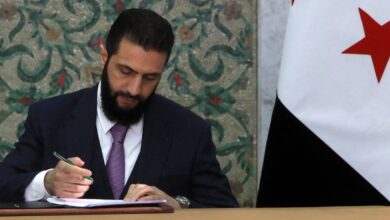سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 21 أذار 2025
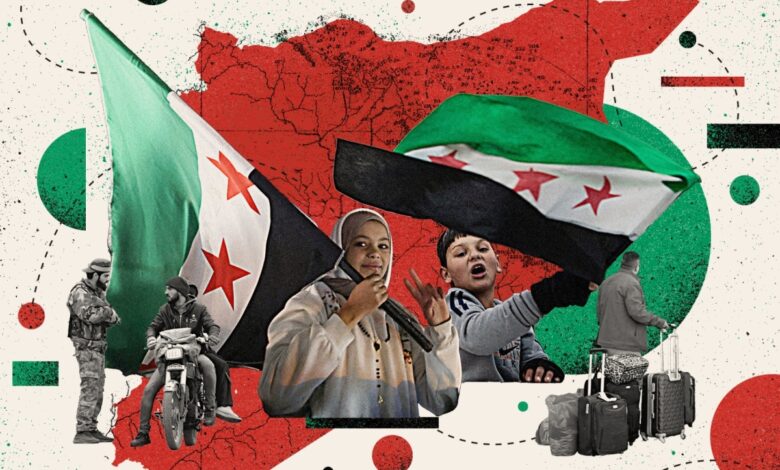
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
——————————–
أدونيس.. لنغسل أيدينا إلى الأبد/ سلمان عز الدين
“ضُبط” أدونيس في وقفة تضامنية مع ضحايا أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري مؤخرًا، والظهور في مناسبة كهذه ليس مما يعيب المرء عادة، بل على العكس هو جلاب للمديح والثناء، سواء أكان المعني شخصًا عاديًا أم شاعرًا “عالميًا”.
غير أن الكثيرين تعاملوا مع أدونيس هنا وكأنه “ضُبط” فعلًا، وواقع الحال يشير إلى أن الرجل لا يملك هذه المرة أيضًا ما يدافع به عن نفسه، أو بالأحرى: لا يملك مريدوه ودراويشه ما ينافحون به عنه، ذلك أن أدونيس نفسه لا يتنازل للدفاع عن مواقفه وأفكاره أمام “الغوغاء”، ولا حتى لتوضيح هذه المواقف والأفكار، وهو الذي لا يزال ينتظر أن تأتي الأجيال القادمة لتفهم شعره وفكره، في تسليم لا يخلو من تلذذ أن معاصريه لا يفهمونه البتة.
وها هو الرجل يكتب نثرًا وشعرًا منذ ستين عامًا، وها هي “الأجيال القادمة” تتوالى، فيما الحاصل أنه يزداد غموضًا والتباسًا.
ولكن لم إصرار البعض على أدونيس أن يخرج ليشرح ويفسر ويُفهمنا؟ ماذا لو خرج غدًا، أو بعد غد، وشرح بواحدة من عباراته الغرائبية النبوئية، كأن يقول: “لأن العصف الجميل قد أتى ولكن الخراب الجميل لم يأت بعد”. ماذا؟ هل فهمتم شيئًا؟
وما يضعف حجة المنافحين أن معظم النقد لأدونيس جاء من أناس أعلنوا بوضوح موقفهم الإنساني والأخلاقي والوطني من أحداث الساحل. قالوا فيها ما قالوه عن أحداث مماثلة سابقة عمت المناطق السورية في عهد النظام البائد وعلى يديه: إنها جرائم موصوفة. كما أدانوا السلطة الجديدة مثلما كانوا قد أدانوا السلطة الساقطة. الشيئ الذي يكشف السبب الأساس لهذه الحملة على الشاعر: لماذا لم يفعل ذلك هو أيضًا؟. لماذا صمت أربعة عشر عاما ملأها النظام البائد مذابح ومجازر، وجاء الآن فقط ليعلن صحوة ضميره؟.
يقيم أدونيس، منذ دهور، فوق السحاب. وعندما اشتعلت الثورة السورية قرر الهبوط والتفرغ بضع ساعات لشؤون هذه الدنيا، فخط رسالة إلى بشار الأسد اقترف فيها ثلاث أو أربع حماقات من العيار الثقيل. قال له: السيد الرئيس أنت رئيس شرعي ومحبوب من السوريين الذين انتخبوك. ثم تكرم بإعطاء بضع نصائح ثمينة، بينها حل حزب البعث الذي رآه السبب الوحيد لغضب الناس من رئيسهم المحبوب. ثم ودع السيد الرئيس وودعنا إلى غير رجعة.
ومن هناك، من فوق، من الطبيعي أن تتغلب الرؤية الميتافيزيقة على الشاعر، فتبدو له المحنة السورية مجرد حلقة جديدة في ذلك الصراع العبثي الذي يخوضه البشر الحمقى منذ الأزل. أناس يتقاتلون لنقص أصلي في عقولهم، لعيب خلقي في غرائزهم.. أما السياسة وشؤونها، أما السلطة السياسة الديكتاتورية وما تقترفه، أما القهر الاجتماعي الواقع على المواطنين.. فكلها مما لا يليق بشاعر رؤيوي أن يكترث به.
ولو أن أدونيس اكتفى بهذه اللامبالاة الفوق أرضية لكان ذلك أخف وطأة، لكنه كان يلتفت بين فترة وأخرى إلينا، نحن سكان هذه الأرض المنكوبة، مقاربًا أزمتنا بطريقة غير مباشرة، من بعيد لبعيد، ووفق رؤيته ذاتها التي لم تتبدل.
ومقاربة أدونيس لا تبتعد كثيرًا عن تلك التي يتشبث بها بعض النخبويين في بلادنا، وتقوم على تقريع الجماهير الجاهلة المحصنة ضد الحداثة، هذه “الغوغاء” التي يغيبها أفيون الشعوب، فتغدو مسؤولة عن إحباط كل محاولات التحديث، بسبب تعلقها بالتراث وتشبثها بالثقافة الشعبية، والتقاليد البالية، والعقل الغيبي، والعلاقات الاجتماعية المتخلفة.
بالمقابل فإن السلطة السياسية، سلطة بشار الأسد وسواه، والنخب الثقافية الدائرة في فلكها، تعفى من النقد والتقريع، فلا مسؤولية تقع على بطشها وجرائمها وشعاراتها الفارغة وحداثتها الزائفة وتحديثها القسري الأجوف، تعاليها وكسلها وإهمالها المتعمد للثقافة وتكبيلها للإبداع. وإذا ما حضر النقد لهذه السلطة، فعبر همس لطيف، أو همهمة غير مفهومة أو كلام إنشاء عام مما يردده الباحثون عن رفع العتب.
وإضافة إلى الجماهير التي يكرهها أدونيس، هناك مذنبون لا يني الرجل يحاربهم بضراوة منذ عقود: أسلافنا الذين أورثونا هذا التراث المكبل، وصاغوا لنا حياتنا الكئيبة هذه، وهو بالطبع يستمر في تحقيق انتصارات باهرة عليهم، ربما لأن منطقه فذ وساحق، أو ربما لأنهم، جميعًا، صاروا أمواتًا منذ ألف عام.
ولماذا قرر أدونيس فجأة أن ينزل إلى عالم البشر وينخرط مباشرة في شؤونهم، فيشارك في وقفة “سان ميشيل” في باريس؟
“استيقظ حسه الطائفي”، يقول كثيرون مشيرين إلى انتمائه إلى المنطقة نفسها التي شهدت أحداث العنف الأخيرة. ويا له من كلام صعب، ليس على أدونيس طبعًا فهو محصن بلا مبالاة كتيمة، ولكن على الذين يضطرون إلى ترديد هذه العبارة مغامرين بأن يخدشوا إحساس أهل الضحايا، ولكن أدونيس هو المسؤول عن ذلك، إذ لطالما جرح إحساس مئات الألوف من أهالي الضحايا السوريين، بصمته حينًا وفزلكته الفارغة حينًا آخر، وبتصويبه السهام إلى كل الأهداف ما عدا تلك التي يتوجب أن توجه إليها في كل الأحيان.
وربما يكون الحل فيما اقترحه البعض: أن نغسل أيدينا من أدونيس مرة وإلى الأبد، فقد صار هذا أمرًا فنتازيًا: هو يصر على مفاجأتنا منذ عقود طويلة، ونحن مصرون على أن نتفاجأ ونصيح: “ياااه غريييب!”.
الترا سوريا
————————————
سوريا بين العالم والداخل.. معركة الاستقلال الثالث/ رائد وحش
20 مارس 2025
علّمَتنا سنواتُ الكارثة أنّ تعليق الآمال على الخارج سراب وتجارة خاسرة. وها نحنُ اليوم، بعد سقوط نظام آل الأسد، نعاين كيف يتعامل العالم مع سوريا بوصفها ملفًا مزعجًا آن أوان إغلاقه، بعد انتهاء مفعول التعامل معه بمنطق إنها أزمة تُدار ولا تُحل، وجراح تُسكّن ولا تُعالج.
ومع تراجع اهتمام اللاعبين الدوليين بقيت سوريا وحيدةً أمام واقعها الداخلي، تواجه معركة استقلالها الثالث: إما أن تتحرّرَ من أوهام التدخل الخارجي، وتستعيد قدرتها على صنع قرارها والتحكم بمصيرها، أو أن تعود مرة أخرى إلى مسار الكارثة.
لماذا يريد العالم تحييد سوريا؟
من ميدان لتصفية حسابات دولية وإقليمية معقدة إلى عبء ثقيل لا يجب التخلص منه وحسب، بل تحييد تأثيره على العالم الخارجي. هكذا ينظر العالم إلى سوريا، دون رغبة جادة في إنقاذها من معاناتها بالمعنى الجاد، بل لمنع تمدّد حرائقها إلى خارج حدودها.
تسعى القوى الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة، إلى منع تأثير سوريا الإقليمي، حيث تواجه أوروبا تحديًا في التعامل مع القضية السورية وسط أولوياتها الأمنية والاقتصادية المتشابكة مع الحرب الأوكرانية. وبسبب استمرار السياسات الأمريكية الانعزالية في عهد ترامب الأول، وبعده بشكل جزئي، والآن في عهده الثاني؛ تُركت أوروبا في موقف حرج، إذ وجدت نفسها وحيدة في مواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية، مما جعلها تركّز على أولويات أكثر إلحاحًا، مثل أزمة الطاقة والاستقرار الداخلي.
ومن أجل هذا راحت هذه الدول تسعى إلى إغلاق هذا الملف عبر تحويل القضية إلى أزمة داخلية مُعلّقة، وتحييدها عن المشهد الدولي دون تقديم إجابات حقيقية لمشاكلها العميقة كإعادة الإعمار، ورفع العقوبات، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تزداد سوءًا مع الوقت. فالعالم قلقٌ لأجل ثلاث قضايا هي: الإرهاب واللاجئون وأمن إسرائيل. ولا يبالي كثيرًا بتحقيق العدالة أو تأسيس مستقبل أفضل، وإنما يريد العمل على ضمان بقاء سوريا تحت السيطرة، بلا تأثير أو تهديد.
تُدار سوريا اليوم عبر توافقات تهدف إلى إبقاء الوضع تحت السيطرة، دون معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الكارثة
لا يريد الغرب حكومة سورية قوية ومستقلة، وفي ذات الوقت لا يرغب في أن تكون سببًا لانهيار شامل يُشعل المنطقة. ولذلك اختار الحل الأسهل: “تجميد الأزمة” بدلًا من حلها. مساعدات إنسانية محدودة تُبقي السوريين على قيد الحياة، وعقوبات مستمرة تكبّل البلاد دون أفق واضح، وتجاهل مستمر للاعتداءات الإسرائيلية التي تحاول صياغة واقع جديد. لكنّه نسي أن تجاهل المشكلات لا يلغيها، فسوريا لن تختفي، ولن تتحول إلى مجرد ملف مغلق بهذه السهولة؛ فالنيران التي تتحرك تحت الرماد قابلة للاشتعال من جديد، والرهان على تجميد الصراع بدلًا من حلّه ليس سوى تأجيل لانفجار آخر لن يكون أحد بمنأى عنه.
تُدار سوريا اليوم عبر توافقات تهدف إلى إبقاء الوضع تحت السيطرة، دون معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الكارثة. ذلك أنّ المشكلة الأمنية انتهت بخروج إيران من المعادلة، والمشكلة المتعلقة بتمدد اليمين المتطرف باتت تجد في سقوط النظام حلًّا للتخلص من اللاجئين السوريين في الدول الغربية. إلى جانب أنّ أوروبا نفسها في قلب أزمة اقتصادية وأمنية متصاعدة، تدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها. فألمانيا، مثلًا، أقرّت حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 500 مليار يورو على مدى السنوات المقبلة، وهو ما سيفرض أعباءً مالية هائلة على المواطنين، مع ارتفاع الضرائب والأسعار، إذ يقول الخبراء إن كل مواطن سيتوجب عليه تسديد 90 ألف يورو من جيبه لتسديد هذه الحزمة المليارية.
تعكس هذه التحولات أن الانكفاء الأوروبي عن الملف السوري ليس مجرد تقصير، بل امتداد مباشر لأولويات سياسية واقتصادية تغيرت جذريًا بعد الحرب الأوكرانية. وكما أشرنا، لن يؤدي تجاهل المشكلة إلى اختفائها، فالمشكلات المشابهة تظل قنابل موقوتة جاهزة للانفجار في أية لحظة، كما هو الحال في غزة قبل السابع من أكتوبر، ولعل الخيار الوحيد الذي يملكه السوريون اليوم هو بناء توافق داخلي حقيقي، لأن البديل هو الاستمرار في حالة الانقسام والتبعية، حيث تبقى البلاد رهينة المصالح الخارجية، وعاجزة عن استعادة سيادتها واستقرارها.
ثلاث قنابل موقوتة
يضع الواقع الدولي المتغير، إلى جانب الأوضاع الداخلية المتفاقمة بعد سقوط نظام آل الأسد، السوريين أمام حقيقة لا مفر منها: لن يكون الخلاص إلا من الداخل.
لم يعد التعويل على القوى الخارجية خيارًا مجديًا، فالرهان على التدخلات الدولية لم يُثمر إلا عن مزيد من التعقيد، بينما المشكلات الحقيقية تزداد سوءًا داخل البلاد.
وقدمت أحداث الساحل السوري الأخيرة مؤشرًا خطيرًا على وصول التوترات الطائفية إلى مستويات كارثية، ليس فقط على مستوى التسبّب بسقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين في مجازر مروعة، بل على مستوى استقرار سوريا بأكملها.
وكشفت تلك الأحداث المؤسفة عن عمق الانقسامات المجتمعية، التي باتت تمثّل العقبة الأكبر أمام بناء دولة مستقرة من جهة نزوع أطراف سورية إلى إثارة الفوضى كرد فعل على المجازر من جانب، فضلًا عن مخاوف متزايدة من مبالغة السلطة في إعادة إنتاج الاستبداد كمحاولة لاحتواء ذلك من جهة أخرى.
وأبرزت الأحداث أسئلة حاسمة حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على ضبط الجماعات المسلحة التي باتت جزءًا رسميًا من قواتها، إذ لم تُبرهن بعد على سيطرتها الفعلية على الأرض، ما يُعزز حالة عدم الثقة الدولية، ويعيق محاولات إزالة أو تخفيف العقوبات أو تحفيز الدعم الدولي. وفي ظل أوضاع مثل هذه يبقى خطر التصعيد مفتوحًا ما لم يتم تبني حلول جذرية تعيد بناء الثقة المجتمعية وتُعزز سيادة الدولة في إنصاف الضحايا الجدد، وإيقاف الشحن الطائفي الذي يجد في جراح الضحايا القدامى التي لا تزال مفتوحة منطلقًا مستمرًا.
وإلى الجنوب، حيث تسعى إسرائيل إلى استغلال الفراغ الأمني وتعمل كي تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي بما يخدم أمنها ومصالحها، كان المشهد الأبرز هو زيارة الوفد الدرزي السوري إلى الأراضي المحتلة. وجاء ذلك تتويجًا لجهود متواصلة تعمل بشكل استراتيجي على خلق واقع أمنيّ جديد، عبر زرع الخلاف بين مجتمع الدروز السوريين، ليكون مقدمة لتقسيم الجنوب إلى مناطق نفوذ إسرائيلية، وفرض مناطق منزوعة السلاح تمنع الدولة الجديدة من بسط سلطتها الكاملة هناك. ورغم أن الدروز السوريين رفضوا أي دعم عسكري إسرائيلي، إلا أن وجود أصوات مؤيدة لذلك يُنبي عن مواجهات مستقبلية، مما يجعل غياب التحرك الحاسم من قبل الحكومة الانتقالية يهدد بتكريس واقع جديد، سيكون من الصعب تغييره لاحقًا.
وبالطبع، لم يكن موقف الدروز موحدًا تجاه الإعلان الدستوري، فبينما دعمته بعض الأطراف، رأت أطراف أخرى أنه لا يمكن الوثوق به ولا بالسلطة الجديدة التي لم تبرهن على التزامها بحماية الحقوق المدنية والسياسية.
وهذا الانقسام مشابهٌ إلى حد كبير للوضع داخل الأوساط الكردية، حيث سمحت الإدارة الذاتية بتنظيم مظاهرات احتجاجًا على مجازر الساحل، لكنها منعت الاحتفال بذكرى الثورة السورية، ما يعكس موقفًا سياسيًا غير ثابت تجاه السلطة الجديدة.
ولهذا يبدو أن توقيع الاتفاق مع “قسد” وانسحاب القوات الأمريكية المرتقب لا يعني نهاية الصراع في الشمال الشرقي للبلاد، بل بداية مرحلة جديدة من إعادة الترتيب الأمني والسياسي، لا سيما مع بروز المخاوف الكردية من الإعلان الدستوريّ الذي بدا لهم عبارة عن إعادة إنتاج لمركزية الحكم، واستبعادًا لهم من العملية السياسية المستقبلية. وبينما ترى الحكومة السورية أن تقديم تنازلات كبيرة في مسألة اللامركزية أمر غير واقعي في ظل مركز هشّ يواجه تحديات داخلية وخارجية، يبقى الأكراد متحدين في رفض الإعلان الدستوري، مما يجعل المسألة الكردية اختبارًا حقيقيًا لقدرة سوريا الجديدة على بناء دولة تعددية.
هذه الملفات الثلاثة (الساحل، الجنوب، والشمال الشرقي) تمثل قنابل موقوتة تهدد بنسف أي استقرار محتمل إذا لم يتم التعامل معها بحكمة. وما يجري اليوم ليس مجرد أزمات متفرقة، بل هي تحديات كبيرة تُعيد صياغة معالم السلطة والهوية في سوريا ما بعد الأسد.
ما الذي يجب على السوريين فعله؟
ليس السؤال: كيف سقط النظام؟ بل كيف تُحكم سوريا وكيف تدار شؤون شعبها ومصالحه؟
ولهذا فإن غياب الرؤية الموحدة، واستمرار الاستقطاب الطائفي، والدفع باتجاه الارتهان للخارج يجعل البلاد عالقة في حالة من الهشاشة التي ستفضي إلى مسارات لا يُحمد عقباها كالتفكك الدائم أو الوصاية الدولية طويلة الأمد، بدلًا من بناء التوافق الداخلي وإنجاحه.
في عالم سريع التغيّر، ومع بناء السلطة الجديدة على أسس هوياتية واضحة، لم يعد أمام السوريين سوى خيار واحد؛ النظر بواقعية إلى مستقبلهم السياسي، والتوقف عن الرهان على خيارات تصعيدية لا طاقة للبلد والناس على تحملها. فمع تصاعد الأحداث الأخيرة، برزت نزعات طائفية في الخطاب العام، يستخدم بعضها المآسي الحالية كأداة للتعبئة، دون أن يسهم في بناء مسار سياسي يمنع تكرار المأساة التي يعرفها السوريون جيدًا. من غير المعقول إنكار الضحايا الذين فقدوا أقاربهم وأحباءهم، لكنّ هذا لا يعني تجاهل أن دوامة العنف ستعيد إنتاج نفسها ما لم يتم كسرها بإرادة سياسية واضحة. ربما يُبرر تركيز الخطاب على الثأر والاستقطاب من زاوية الألم، لكنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والقطيعة بين السوريين.
الدعوة إلى خطوات سياسية واضحة، مثل تشكيل لجان محلية للحوار، وإيجاد آليات للمساءلة العادلة، هي وحدها القادرة على إخراج الجميع من هذه الحلقة المفرغة. فلا يمكن بناء مستقبل لسوريا على خطاب يغذّي الانقسام، بل على إرادة للخروج من المعادلة التي أبقت الجميع رهائن لدوائر العنف المتكررة.
وعلى المقالب الآخر، السلطة السورية الجديدة مطالَبة باتخاذ قرارات صائبة ورشيدة، بدلًا من تفسير كل معارضة على أنها مؤامرة خارجية أو بقايا للنظام السابق. فليس كلّ معارضةٍ تنتمي للفلول، وليس من الحكمة التعامل مع المعارضين بعقلية قناة الدنيا التحريضية أو تطبيل أبواق نظام الأسد، بل معالجة الملفات العالقة بجدية، خاصة ما يتعلق بالعناصر غير المنضبطة أو الأجنبية في صفوف القوات الرسمية، لأنها تشكل عقبة أمام أي استقرار مستقبلي، إلى جانب تأثير ذلك على شرعية السلطة، ولا يزال النقد مستمرًا لقبول كوادر غير سورية في مؤسسات سيادية.
إلى جانب ذلك هناك ضرورة إلى تحريم الخطاب التحريضيّ الذي يُكفّر السوريين، ويعتدي على المجال العام، ويريد بلدًا للون واحد من الناس.
هل يتعلم السوريون من الماضي؟
العالم الذي يعول عليه بعض السوريين لديه أولويات أخرى، وليس مهتمًا بدفع الأطراف السورية نحو تسوية حقيقية، ولن يقدم لسوريا أكثر من المساعدات الإنسانية المحدودة التي تمنع الانهيار الكامل، دون أي نية للعمل على حلّ سياسي شامل.
من هنا، فإن مفتاح الاستقرار بات واضحًا أمام السوريين: مصالحة وطنية وحوار داخلي حقيقي، يبدأ من بناء الثقة بينهم، لا من تفجير صراعات تُعيد المأساة إلى بدايتها.
وحدهم السوريون من يقررون مصير وطنهم، ولطالما أثبتت التجارب المريرة أنّ الخلاص الحقيقي لا يأتي من الخارج، بل من إرادة وطنية واعية ترفض العودة إلى الوراء، وتصرّ على بناء دولة تستوعب الجميع، دون إقصاء أو استبداد.
هي معركة الاستقلال الثالث، وهذه المرة ليست ضد مستعمر ولا طاغية، بل ضد الفوضى والتدخلات الخارجية. والتحدي الحقيقي هو القدرة على بناء وطن لا يتحكم فيه الآخرون، ولا تُمزقه صراعات الداخل.
الترا سوريا
——————————————
أسئلة الراهن السوري.. حاشية على هامش الاستحقاقات الوطنية الكبرى/ حسان الأسود
2025.03.21
عند البدء بكتابة هذه المقالة سيكون قد مرّ مئة يوم على إسقاط أعتى نظامٍ استبدادي في العالم، ويومان على الذكرى الرابعة عشر لاندلاع ثورة الحرية والكرامة من درعا. لقد شاهد الملايين من البشر في أربع جهات الأرض بعضًا من فصول التحوّل الدراماتيكي السريع في المشهد السوري، أقلّه من باب فرحة السوريين والسوريات البادية في وجوههم وعيونهم وزغاريدهم وغنائهم ورقصهم في الساحات والمعابر والمطارات، أو في فجيعتهم وحزنهم وألمهم على أبواب السجون وأفرع المخابرات والمقابر الجماعية. وبعد هذه الفترة الوجيزة من البدء في مسيرة تخطّي ستة عقود وأكثر من الديكتاتورية والتسلّط، بدأت التساؤلات المُحقّة تطفوا على السطح، بل وغير المحقّة أيضًا. خارجيًا، أين ستكون سوريا في محيطها العربي والإقليمي، وما هو دورها الذي يمكن أن تلعبه في الشرق الأوسط الجديد الجاري تشكّله؟ أما داخليًا، فكيف سيكون شكل الدولة ونظام الحكم، هل سيتمكن أهلها من إنشاء عقد اجتماعي جديد بينهم، وهل ستتمثل كل الجماعات السورية في الدستور العتيد الجديد، وهل سيتمكنون من بناء ما هدّمته الحرب، وهل سيتركون وحيدين أم سيمدّ العالم أياديه لهم، وهل سيعود المهجرون والنازحون لمدنهم وقراهم، وهل سيستطيعون إنجاز المصالحة الوطنية، وهل سيتمكنون من محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا؟ ألف سؤال وسؤال محقّ يمكن طرحه هنا في هذا المقام، وكثيرٌ غيرها أيضًا تلتبس بين المشروعية والسفسطة حسب مكان طرحها وزمانه والمطالبين بها والمتوقّع منهم الإجابة عنها.
عمِلت مجموعات كثيرة من النخب المثقّفة والسياسية والمدنية خلال أعوام الثورة على إنجاز مجموعة من التصورات لليوم التالي لسقوط النظام، وتمّ بذل جهدٍ تنظيريٍ كبيرٍ في عدّة محاور، ويمكن بلا شكّ الاستفادة منها في المرحلة الراهنة كما في المراحل الانتقالية اللاحقة وما يتبعها في حال الاستقرار. لكنّ الواقع أكبر دومًا حتى من الخيال، فسرعة تدحرج الأمور وانهيار الحلف الداعم للنظام والوصول إلى قلب العاصمة جعلت الإجابات أكثر صعوبة وتعقيدًا بما لا يمكن تصوّره. نحن أمام دولة منخورة بالفساد في كلّ مفاصلها بلا أي استثناء يخزي عين إبليس، وبحضرة شعبٍ منقسمٍ على هويّته التي مزّقها طول العهد المظلم، يعاني أوجاعًا لا براء منها بعشرات السنين، ونحن أمام واقعٍ دوليٍ وإقليمي ترسمه مباضع التدخّل الخارجي ودبابات جيوش الاحتلال، فكيف لنا أن نتصوّر الحلول ضمن حقول الألغام الرهيبة هذه؟ وكيف يمكن إرضاءُ هذه الجموع الحاشدة التي تنفّست هواء الحريّة الطلق، وكيف لنا أن نميّز بين ما يُرفع من شعارات بقصد تثبيت مكتسبات الحريّة الفائضة وبين تلك التي يستغلّها آخرون لزعزعة الأمن الذي لم يستتبّ نهائيًا بعد؟ كيف يمكن الاطمئنان إلى أنّ عشرات آلاف الشبيحة ومئات آلاف عناصر المخابرات والميليشيات، التي ذابت مثل ذرّة ملح في ماء يغلي، لن تعمل على التخريب الناعم أو الخشن ولن تبدأ الثورة المضادّة بعد أن خلعت جلدها ولبست أثوابًا جديدة؟
أسهَمَ أهلُ سوريا بإغناء لغتهم السياسية بالمصطلحات والمفاهيم خلال العقود الماضية، وتكثّفت إسهاماتهم خلال عهد الثورة، فرأينا كلمات تختزل صفحات من الشرح، مثل منحبكجي وشبّيح وأخيرًا مكوّع! وهذا المصطلح الأخير يحملُ في طيّاته مخزونًا هائلًا من بعد النظر والحكمة والمخاوف في آن معًا. فأيّ عبقريّة تلك التي قرأت تحوّلات مواقف فئات كثيرة من هؤلاء وأولئك الذين ساندوا النظام أو تماهوا معه أو دعموه، وأيّ روحٍ عظيمةٍ ظهرت في التعالي على الجراح رغم أنّها ما فتئت تكبر وتتسع وتزداد مع كل سجن يُفتح وكل مقبرة تُكتشف وكلّ مفقودٍ يُعلنُ الحداد عليه!؟ مذهلٌ هذا الشعبُ وعظيم. كم تعرّض أهل سوريا للاضطهاد والتنمّر والتمييز داخل بلادهم وخارجها، وكم أثقلت كواهلهم أعباءٌ لا يد لهم فيها، ومع ذلك لم يخضعوا لمن كان يدفعهم للعودة إلى حظيرة الطاغية، في حين تراهم الآن يحجّون زرافاتٍ ووحدانا توقًا لأرضهم وناسهم وهواء الحريّة!
وعلى الضفّة الأخرى، هل يظنّ المجرمون والقتلة أنهّم سيفلتون من العقاب، وكيف يمكن أن يعيش آلاف الوحوش بين ظهرانينا ونحن نعرفهم ونعرف ما قاموا به، ألم يحاولوا الانقلاب وإشعال الفتن قبل أسابيع في الساحل السوري بدعم من إيران وميليشيا حزب الله الإرهابي؟ هل يمكننا التغاضي عن العربدة الإسرائيلية وتماهي بعض ضعاف النفوس معها واستقوائهم بها في وجه الإدارة الجديدة؟ ألا يرى هؤلاء أنهم يقفون مع عدونا التاريخي ضد بلدنا وليس ضد الإدارة التي قد نتفق معها وقد نختلف، لكنّ معارضتها من داخل سياج الوطن شيء والعمالة للعدو شيء آخر؟ أسئلة كثيرة ومخاوف متعددة وعقبات أكبر تقف أمامنا جميعًا، وهي بحاجة لحلول سوريّة تُثري اللغة والسياسة والاجتماع أيضًا، وتبدأ الإجابة عليها ببناء مسارٍ متكاملٍ للعدالة الانتقالية، يضع على رأس أولوياته محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتطهير مؤسسات الدولة من الفلول والفاسدين.
التحديات كبيرة جدًا، منها تحدي تأمين وسائل العيش للشعب المنكوب، ومنها تحدي استعادة وحدة سوريا الذي بدأ فعلًا من خلال ورقة التفاهم التي وقعها الرئيس الشرع مع الجنرال عبدي قبل عدّة أيام، وتحدي الانخراط في الشرق الأوسط الجديد والعودة للحضن العربي، ثم تحديات إعادة الإعمار وإنتاج العقد الاجتماعي السوري الجديد. ستكون القوى السياسية أمام امتحان الوطنية وامتحان العمل المشترك لإنجاح الانتقال من عصر الديكتاتورية إلى عصر الحرية والكرامة. سيكون على الإدارة السورية الجديدة أن تعي أيضًا أنّ مؤتمر الحوار الوطني لم يحقق ما تصبوا إليه غالبيةٌ وازنةٌ من الشعب باعتباره أهمّ استحقاق سوري أُهدرت فرصته، وأنّ عليها استدراك ما فاتها تحقيقه من خلال التحضير لمؤتمر وطني تأسيسي جديد، على مهل وبتأنّ وحكمة، بحيث يرتُقُ كلَّ فُتُوقِ العقد الاجتماعي، ويُعيدُ ترميم كسور الهويّة الوطنية، ويبني العهد السوري الجديد، عهدَ المواطنة وكرامة الإنسان وحقوقه. وعليها أيضًا أن تعي أنّ تعيينات اللون الواحد ممن يحققون شرط الولاء بغض النظر عن الكفاءة لن تنهض بالبلاد، وعليها أن تعي أيضًا أنّ التشاركية لا تعني الكلام المعسول، بل التطبيق على أرض الواقع فعلًا. على السوريين جميعًا، شعبًا وإدارة جديدة أن يعوا أنّ صراع المصالح الإقليمية والدولية على أرضهم لا يقود بالضرورة إلى تحقيق مصالح سوريا والسوريين، بل إنّ ذلك يحتاج لكثير من الحكمة للخروج من حبائل التبعية وللبناء على المصالح المشتركة من دون تفريط بوحدة البلاد وسيادتها. كل هذه وغيرها مواضيع راهنة وأسئلة محقّة على هامش الاستحقاقات الوطنية الكبرى، فهل نستطيع الإجابة عليها معًا؟
تلفزيون سوريا
———————–
محاسبة واحدة لمصلحة سورية ولبنان/ باسل. ف. صالح
21 مارس 2025
سرعان ما يتكشّف بعد كلّ جريمة، أن الحاجة إلى العدالة والمحاسبة في سورية لا يمكن حصر مفاعيلها في الداخل السوري فقط. وتزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة لاندلاع الثورة السورية ورحيل الطاغية (قبل أيّام قليلة)، ينبغي التذكير بأن دولة سورية ديمقراطية، تساوي بين جميع السوريين أمام القانون، وتحمي التنوع والتعدّد السوري جزءاً من التنوع والتعدّد في المنطقة بمجملها، وتعترف بالجماعات، وتعكس ذلك الاعتراف في الدستور وبمصادره التشريعية، وفي الممارسة السياسية الديمقراطية وحرّية التعبير عن الرأي… هذه الدولة السورية هي ما انتفض من أجله الشعب السوري، ولطالما كانت الحاجة إلى المحاسبة حاجةً من أجل مستقبل الشعبين السوري واللبناني، ولاستقرارهما.
لطالما ردّد النظام السوري السابق، وحلفاؤه في لبنان، أن اللبنانيين والسوريين “شعب واحد في بلدَين”. أو بالأحرى، كان هذا الشعار بمثابة ردّ تلقائي على أيّ إمكانية للتمييز بينهما شعبَين مستقلَّين ولهما خصوصيتيهما، ويعيشان في دولتَين مختلفتَين، إلا أن الأيديولوجيّة الاستبدادية العائلية التي مارستها الأنظمة البعثية، خصوصاً في سورية، كانت تستخدم الشعار لإسكات كلّ معارض وللإطاحة بأيّ محاسبة، من دون أن تكون لها أيّ مفاعيل تكاملية على الشعبين امتداداً طبيعياً وجيوسياسياً ومصلحياً، امتداد وتكامل يقومان على الاحترام المتبادل، وليس على مصادرة الحرّيات والانتظام السياسي ونهب خيرات الشعبين معاً. على الرغم من أن معظم المفكّرين السوريين واللبنانيين لم يتردّدوا في التذكير بهذا التكامل، خصوصاً أولئك الذين نُكّل بهم وصولاً إلى اغتيالهم. على سبيل المثال لا الحصر، ألم يقل سمير قصير (تشير أصابع الاتهام إلى كلّ من نظام آل الأسد وحلفائه في لبنان بالضلوع باغتياله، كما في كم الاغتيالات التي شهدها لبنان خصوصاً في عام 2005 وما تلاه): “حين يزهر ربيع العرب في بيروت، فإنه يُعلِن أوان الورد في دمشق”؟
لكن، لنظام آل الأسد مسيرةٌ حافلةٌ بشعارات الحقّ التي يراد بها باطل، والتي لم تنتج إلا القمع والترهيب والإقصاء والاغتيال والنهب المنظّم، كما لم تنتج سوى صراعات أهلية وحقد متبادل، تُصرَف نتائجهما في مصلحة النظامين والقوى التي تهيمن عليهما فقط. أمّا اليوم، ومع صعود القراءات اليمينية في العالم بمجمله، يتكرّس عند بعضهم أن ميل الموازين في هذا الاتجاه أو ذاك، في سورية أو في لبنان، يمكن عزله عن الدولة الأخرى، خصوصاً الصراعات المسلّحة والأهلية والمجازر الطائفية. لكنّه ليس إلا أضغاث أحلام لطالما تعلّق في حبائلها هواة السلطة والتسلّط من الطرفَين، تماماً كما حوّل نظام آل الأسد سورية ولبنان مرتعاً لمفاوضاته وعملياته وتصفية حساباته، ومزيداً من سلطانه. والعكس بالعكس أيضاً، حين تدخّل حزب الله لقتال الشعب السوري، واستخدم مستقبله وتطلّعاته كما استخدم مستقبل الشعب اللبناني وتطلّعاته وسيلةً لمصلحته ومصلحة إيران من خلفه. لكن حقيقة الواقع الجيوسياسي، والتموضع والتعدّد الطائفي والمذهبي والديني والإثني، الممتد في المنطقة، يشي بعكس ذلك تماماً. فأيّ شرارة في سورية لن يطول الوقت لتجد هشيماً قابلاً للاشتعال في لبنان، في هذه اللحظات المتأجّجة على وجه التحديد.
قد يظن بعضهم أن إمكانية الالتفاف على المحاسبة عن الجرائم التي طاولت العلويين في مناطقهم (وهنا نتكلّم عن المدنيين الذين غصّت الوكالات والأنباء بصورهم وأخبارهم وفيديوهاتهم، وليس عن بقايا مليشيات الأسد والنظام الإيراني، التي ما زالت تصرّ على استخدام السوريين واللبنانيين، وغيرهما من شعوب، وقوداً لمصالحها) لن يكون له ذلك الأثر الكبير في لبنان وفي المنطقة، كما سبق واعتقد بعض آخر أن الجريمة المباشرة التي ارتكبها نظام الأسد بحقّ السوريين، وشارك فيها حلفاؤه من اللبنانيين وبقية المليشيات، واستمرّت ما يقارب عقداً ونصف العقد، وطاولت (خصوصاً) السوريين السنّة، لن تنعكس في لبنان، سواء في الصراعات أو في الحلول.. ذلك كلّه محض أوهام، والدليل أن التأجّج الطائفي في لبنان بلغ مداه في غير منطقة.
من هذا المنطلق، هناك حاجة ضرورية في البلدين للمحاسبة الجدّية، مع مرور ذكرى اندلاع الثورة ورحيل الطاغية، للمحافظة على سورية وعلى لبنان، وعلى البلدان المحيطة، وليس لبناء طغيان معاكس. إذ يكفي هذان البلدان، وهذه المنطقة، الخطر الداهم الذي يتربّص بها نتيجة الأطماع والصراعات المحتدمة في المنطقة (وعليها)، ولا سيّما من إسرائيل، التي لن تتلكأ عن تغذية واستخدام أيّ تأجّج طائفي لتجيّره في صالحها، الذي قد تصل مفاعيله إلى تقسيم الدول المحيطة، أو إلى حروب وصراعات أهلية ومواجهات دامية، على حساب وحدة ومستقبل واستقلال البلاد، وعلى حساب دماء المدنيين فيها.
والكلام أعلاه لا يعني (ولا يبرّر) تدخّل أيّ دولة في دولة أخرى، كما أنه لا يعني أن غاية السلام الداخلي لشعب ما ليست إلا وسيلةً لغاية سلام شعب آخر. بل على العكس، هي حاجة ملحّة للدولة وللشعب ذاته. فالإصلاح الجدّي والجذري والتعدّدي والديمقراطي حاجة لاستقرار سورية، وتطلّع إلى مستقبل الشعب السوري، وغاية ومطلب قائمان في ذاتهما ولذاتهما. لكنّ هذا المطلب وهذه الغاية، يتخطّيان غائيتهما المباشرة المحصورة في الداخل السوري ليطاولا السلم الأهلي في لبنان بشكل مباشر، والسلم الأهلي في المنطقة بشكل غير مباشر، خصوصاً أن المنطقة في خضم عملية إعادة رسم الخريطة.
————————-
إدلب.. مختبر اجتماعي أعاد تشكيل الهوية السورية/ إياد أحمد شمسي
2025.03.21
على مدى أربعة عشر عامًا من الثورة السورية، خاض السوريون تجربة اجتماعية عميقة ومؤلمة في آن واحد. هذه التجربة، التي كانت نتيجة لتشريد الملايين وتداخل المجتمعات المحلية في ظروف قهرية، شكّلت مختبرًا اجتماعيًا غير مسبوق. في هذا المختبر، أعاد السوريون اكتشاف أنفسهم ليس كأفراد فقط، بل كأمة متعددة المكونات والخصوصيات الثقافية. لم تكن هذه التجربة مجرد استجابة للأزمة، بل كانت إعادة تشكيل تدريجية للهوية السورية على أسس جديدة قوامها التعددية، والتفاعل، والانفتاح.
النظام المخلوع وإرث التفكيك المجتمعي
لأكثر من خمسة عقود، انتهج النظام المخلوع سياسة قوامها تفكيك الروابط الاجتماعية بين السوريين. كانت فلسفته تقوم على ترسيخ الانقسامات الجغرافية، والاقتصادية، والطائفية، مما عمّق الشعور بالانعزال داخل المجتمع السوري. كانت المدن معزولة عن القرى، والمناطق الريفية مُهمّشة ومغلقة على نفسها، بينما عانت البوادي من التهميش الكامل، وأصبحت العلاقات الاجتماعية محكومة بالشك والخوف.
هذا التفكك كان وسيلة لضمان السيطرة السياسية، لكنه في الوقت ذاته أضعف الهوية الوطنية السورية. الهوية التي كان يفترض أن تكون جامعة أصبحت مجزأة، مشوهة، وفاقدة للتماسك. لكن الثورة السورية، رغم قسوتها، أحدثت شرخًا في هذا النظام الاجتماعي المفروض، وخلقت فرصة لإعادة بناء هذه الهوية على أسس أكثر عدالة وشمولية.
إحدى أبرز نتائج هذا التحول كانت تجربة إدلب، التي أصبحت مختبرًا اجتماعيًا طبيعيًا، حيث جمع السوريون من مختلف الخلفيات والبيئات في مساحة واحدة، ليعيشوا تجربة تعايش مكثفة أعادت تعريف العلاقات بينهم رغم ضيق المساحات وعجز الإمكانيات وصعوبة الظروف.
إدلب: فضاء اجتماعي لإعادة تشكيل الهوية
إدلب، التي أصبحت ملاذًا لملايين السوريين من مختلف المحافظات، لم تكن مجرد مكان للإقامة المؤقتة، بل كانت نقطة التقاء بين ثقافات ولهجات وعادات متنوعة. في هذا التداخل، بدأ السوريون يعيدون اكتشاف بعضهم البعض. لأول مرة، جلس الفلاح القادم من الجنوب بجوار التاجر القادم من الشمال، وبدأ الحديث بينهما يكشف عن قواسم مشتركة لم يكونوا يدركونها.
في إدلب، ظهرت أنماط جديدة من التفاعل الاجتماعي. اللهجات المختلفة لم تعد تُعتبر عائقًا، بل أصبحت وسيلة للتواصل والتعرف على الآخر. التقاليد والعادات التي بدت في البداية غريبة تحولت إلى مصدر إلهام وتعلم. كانت إدلب مثالًا حيًا على أن التنوع يمكن أن يكون عامل قوة، وليس سببًا للفرقة.
هذا التفاعل اليومي لم يكن مجرد إعادة تشكيل للهوية الجمعية، بل كان درسًا عميقًا في فهم القيم المشتركة التي يمكن أن تجمع بين مختلف المكونات الاجتماعية السورية.
تجربة الدروز في إدلب: نموذج للتعايش والتكامل الاجتماعي
في سياق إعادة تشكيل الهوية السورية، تبرز تجربة الطائفة الدرزية في منطقة جبل السماق شمال غربي إدلب كمثال حي على قدرة المجتمعات المتنوعة على التعايش والتكامل. يقطن في هذه المنطقة نحو 10 آلاف نسمة من أتباع الطائفة الدرزية، موزعين على 14 قرية. بعد سنوات من الفوضى والتهميش، شهدت هذه القرى تحسنًا ملحوظًا في البنية التحتية والخدمات الأساسية منذ عام 2017، تحت إدارة حكومة الإنقاذ السورية وفقًا لتقرير ودراسات نشرت سابقا.
وفي 8 يناير 2025، أكد وجهاء الدروز في إدلب أنهم يعيشون في حرية تامة دينيًا واجتماعيًا، مشيرين إلى أن الحقوق التي سُلبت منهم سابقًا قد أُعيدت إليهم. عطا مرعي، أحد وجهاء الطائفة، أوضح أن “تجربتنا مع حكومة الإنقاذ بدأت منذ ما يقارب 9 سنوات، حصلنا من خلالها على كامل حقوقنا التي أخذت منا في جبل السماق بوقت سابق من قبل بعض الفصائل”.
هذه التجربة تعكس إمكانية تحقيق التعايش السلمي بين مختلف المكونات السورية، وتؤكد أن التنوع يمكن أن يكون مصدر قوة وإثراء للهوية الوطنية. كما أنها تدعو إلى إعادة النظر في الصور النمطية والتخوفات المرتبطة بالتعددية، وتبرز أهمية الحوار والتفاهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
تجربة مسيحيي إدلب: بين عودة العائلات وإحياء الطقوس
رغم أن أعداد المسيحيين في إدلب تُعد قليلة مقارنة بالمكونات الأخرى، فإن تجربتهم خلال سنوات الثورة تقدم نموذجًا بارزًا لتحولات التعايش في المنطقة. وفقًا لتقرير نشره موقع تلفزيون سوريا في يوليو 2024، عادت 30 عائلة مسيحية إلى منازلها في بلدات وقرى إدلب، مع تسهيلات قدمتها “حكومة الإنقاذ” لضمان استقرارهم وتذليل العقبات أمام المزيد من العائلات للعودة.
من جهة أخرى، ذكرت إندبندنت عربية أن “هيئة تحرير الشام” سمحت للمسيحيين بإحياء طقوسهم الدينية، حيث احتفلوا بعيد القديسة آنا في كنيسة اليعقوبية للمرة الأولى منذ عقد، وسط حراسة أمنية مشددة.
على الرغم من قلة أعدادهم، تعكس هذه التجربة تطور واقع التعايش في إدلب، حيث أصبحت المنطقة مساحة لتفاعل أكثر انفتاحًا، يعزز من مفهوم التكامل بين مختلف مكونات المجتمع السوري، ويمهد لإعادة تشكيل الهوية الوطنية على أسس من التفاهم والتعايش.
“بيت في كل بلد”: فلسفة البيت المشترك
منذ القدم، كان المثل السوري يقول: “ابنِ بيتًا في كل بلد”، وهو تعبير عن أهمية العلاقات الإنسانية كجسر للتواصل والانتماء. تجربة إدلب جسدت هذا المثل بشكل حي. لكل سوري عاش في إدلب ذكريات وروابط جعلته يشعر أن له بيتًا هناك. وفي المقابل، حمل كل شخص عاد من إدلب إلى مدينته أو قريته جزءًا من روح إدلب وثقافتها.
إدلب لم تكن مجرد مأوى، بل رمزًا لفكرة البيت المشترك. هذه الفكرة تقوم على أن لكل إنسان مكانًا يمكنه أن ينتمي إليه، بغض النظر عن خلفيته أو أصله. إدلب أظهرت أن سوريا بأكملها يمكن أن تكون بيتًا مشتركًا للسوريين جميعًا، إذا ما تجاوزوا الحواجز التي فرضها النظام المخلوع.
هذه الفلسفة لا تمثل مجرد حلًا اجتماعيًا للأزمة السورية، بل هي أساس يمكن البناء عليه لإعادة تشكيل الهوية الوطنية. إدلب أظهرت أن الهوية السورية يمكن أن تكون شاملة، تتسع للجميع دون إقصاء أو تمييز.
إرث المختبر الاجتماعي في المستقبل
التجربة التي عاشها السوريون في إدلب لا تتوقف عند حدود الأزمة الحالية. هذا المختبر الاجتماعي أنتج إرثًا يمكن أن يشكل أساسًا لمستقبل سوريا.
1. تعزيز الهوية الجمعية
التفاعل اليومي بين السوريين في إدلب خلق وعيًا جديدًا بهويتهم المشتركة. هذه الهوية، القائمة على التعددية والاحترام المتبادل، يمكن أن تكون أساسًا لمجتمع أكثر تماسكًا في المستقبل.
2. إعادة بناء العلاقات الاجتماعية
العلاقات التي تشكلت في إدلب أصبحت جزءًا من نسيج اجتماعي جديد يربط بين مختلف المناطق السورية. هذه الروابط يمكن أن تتحول إلى شبكات تعاون واسعة تُسهم في تحقيق التنمية وإعادة الإعمار.
3. تصحيح إرث التمييز
إدلب قدمت نموذجًا عمليًا لتجاوز التمييز والتقسيم الاجتماعي. التفاعل المباشر بين سكانها كان بمثابة عملية لتفكيك الصور النمطية وإعادة بناء الثقة بين المكونات المختلفة.
4. دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي
الشراكات التي تشكلت في إدلب بين أصحاب المهن المختلفة أظهرت إمكانية التكامل الاقتصادي بين المناطق. هذا التكامل يمكن أن يكون قاعدة للتنمية المستدامة التي تستفيد من تنوع الموارد البشرية والطبيعية في سوريا.
البعد الفلسفي والاجتماعي لإدلب
إدلب ليست مجرد مدينة أو محطة عابرة في مسار الثورة، بل هي نموذج لفكرة أعمق تتعلق بإعادة تعريف الانتماء والهوية. من منظور علم الاجتماع، ما حدث في إدلب يمثل تجربة تحول اجتماعي عميقة، حيث واجه الناس تحدي إعادة بناء علاقاتهم وهويتهم في ظل ظروف قاسية.
هذه التجربة تعكس الفكرة القائلة بأن الأزمات ليست بالضرورة مدعاة للتمزق، بل يمكن أن تكون فرصة للتجديد وإعادة البناء. إدلب أثبتت أن المجتمعات، حتى في أصعب الظروف، قادرة على اكتشاف إمكانيات جديدة للتعايش والتعاون.
خاتمة: سوريا الجديدة تبدأ من إدلب
إدلب، التي احتضنت السوريين من كافة المناطق، ليست مجرد مكان جغرافي، بل هي رمز لفكرة البيت المشترك. إنها المكان الذي أعاد للسوريين إيمانهم بقدرتهم على تجاوز الانقسامات، وبناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا.
التجربة الاجتماعية التي شهدتها إدلب تحمل في طياتها إمكانات هائلة لمستقبل سوريا. هذا المختبر الاجتماعي سيكون أساسًا لبناء سوريا جديدة، حيث تكون الهوية الوطنية جامعة، والروابط الاجتماعية متينة، والثقافة الاقتصادية قائمة على التعاون والتنمية.
في سوريا المستقبل، ستبقى إدلب رمزًا لفكرة أن لكل سوري بيتًا في كل زاوية من بلاده، وأن سوريا كلها يمكن أن تكون بيتًا يتسع للجميع، بروح الوحدة والتنوع التي تمثلها إدلب.
تلفزيون سوريا
——————————-
رسالة بوتين إلى الشرع… هل تدشّن مرحلة تطبيع العلاقات؟
أكد فيها استعداد بلاده لتطوير التعاون في المجالات كلها
موسكو: رائد جبر
20 مارس 2025 م
تكتسب الرسالة التي أعلن الكرملين، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهها إلى نظيره السوري أحمد الشرع، أهميةً خاصةً في مضمونها وتوقيتها، خصوصاً على خلفية التطورات الأخيرة، التي شهدتها مناطق الساحل السوري، والتحديات المتزايدة التي تواجهها القيادة السورية في إطار جهود تعزيز الاستقرار الداخلي، وتطوير الانفتاح على المحيطَين الإقليمي والدولي.
وقد أعلن الكرملين أن بوتين شدَّد في رسالته على استعداد بلاده لتطوير التعاون مع السلطات السورية في المجالات كلها.
وقال الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن الرسالة حملت تأييداً لجهود القيادة السورية الموجهة نحو «تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم ضمان سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها».
لم يحدِّد بيسكوف تاريخ توجيه الرسالة، وما إذا كانت سُلِّمت عبر مبعوث، لكن بدا من حديثه خلال الإفادة اليومية، أن بوتين وجه رسالته الأربعاء. وحملت الرسالة صياغةً لافتةً، فهي تضمَّنت تأكيداً على توجه موسكو لـ«تطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في كامل نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي؛ من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الروسية – السورية الودية تقليدياً».
ومع الأهمية التي حملها هذا المضمون، وحِرصِ بوتين على تأكيد توجهه لإعادة ترتيب العلاقة وإطلاق تعاون جدي و«عملي» مع القيادة السورية، فإن أهمية توقيت الرسالة على خلفية نجاح دمشق في مواجهة تداعيات أحداث الساحل، تكتسب بعداً لافتاً؛ لأن أصابع اتهام كانت قد وُجِّهت إلى موسكو بشكل غير مباشر، بأنها دعمت أو غضت الطرف عن تحرك عسكري لفلول النظام المخلوع. واستندت الاتهامات إلى أن عشرات الضباط السابقين لجأوا إلى روسيا بعد إطاحة نظام بشار الأسد.
ولم ترد السلطات الروسية على المستوى الرسمي على هذه الاتهامات، واكتفى الكرملين ووزارة الخارجية بالإعلان عن قلق جدي؛ بسبب الاضطرابات في منطقة الساحل السوري التي أسفرت لاحقاً عن ملاحقات وتصفيات جسدية طاولت مدنيين.
في هذا السياق أبلغ مصدر دبلوماسي روسي «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن موسكو لا علاقة لها بأحداث الساحل السوري، وأكد أن السلطات الروسية لا تدعم أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار في سوريا.
على هذه الخلفية تبدو رسالة بوتين «متعمدة في لهجتها وتوقيتها»، وهي تحمل إشارةً واضحةً إلى استعداد موسكو لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على التعاون بما يلبي مصالح الطرفين.
وكان بوتين قد تحدَّث للمرة الأولى، عبر الجوال مع الرئيس السوري الجديد في فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلال المكالمة على «الموقف الراسخ الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا». وأكد استعداد موسكو للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.
من جانبه أشار الشرع خلال تلك المكالمة، إلى «العلاقات الاستراتيجية القوية» بين البلدين.
وتخوض موسكو مفاوضات عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية مع السلطات السورية لوضع أسس جديدة للعلاقة مع دمشق.
وفي يناير (كانون الثاني) قام ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيارة إلى دمشق كانت الأولى لمسؤول روسي بعد إطاحة الأسد. وأعلن الدبلوماسي الروسي المخضرم بعد جولة حوار مع القيادة السورية أنه أجرى «محادثات بنّاءة وإيجابية». وعكست نتائج الزيارة أنها نجحت في «كسر الجليد» بين الطرفين، وأطلقت مسار التفاوض حول ترتيب جديد للعلاقة بينهما.
وقدَّمت دمشق مطالب عدة إلى القيادة الروسية، بينها المساعدة في تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، عبر رفع الغطاء عن رموز النظام السابق، وإعادة الأموال المنهوبة التي تقول تقارير، نفت موسكو صحتها، إنه تم تهريبها إلى روسيا في وقت سابق.
وأبدت دمشق استعداداً لمناقشة أسس جديدة للوجود العسكري الروسي في قاعدتَي «حميميم» الجوية و«طرطوس» البحرية.
من جهتها، أكدت موسكو استعدادها للعب دور إيجابي نشط في ملف الحوار السوري الداخلي، وترتيب الوضع في المرحلة الانتقالية، واستخدام دورها بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي؛ للمساهمة في رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تحدَّثت موسكو عن استعدادها للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية السورية، ولمّحت إلى احتمال إعفاء دمشق من الديون المستحقة لموسكو في إطار مساعدة السلطات الجديدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.
——————————————-
الصحفيون السوريون: المهنية وأحقّية البكاء/ رهام مرشد
مأزق الكتابة عن أقبية المعتقلات وأبناء جلدتنا
19-03-2025
أن تكون سورياً أولاً، وصحفياً ثانياً، في المئة يوم التي مضت على سقوط النظام، يعني أن تجرحك زوايا القصص التي تبحث عنها، أن تخدش نفسك قصداً لأنك نجوت، وأنت تسمع قصص الموت الممتد وتراه دون تجميل. روايات ثقيلة، وأقل ما تفعله أن تبكي، أن تترك مهنيّتك وحيادَك وقواعد المقابلات الصحفية التي تعلّمتها، لتشارك من نجا إحساسه وهو يروي تجربته. أنت طرف في هذه المسارات مهما هربت، أنت الآن لست صحفياً جاء ليحقق السبق ويفهم ما حدث، بل هذه قصص أبناء جلدتك، تنقلها إلى العالم الذي شاهدها مراراً ولم يحرك ساكناً، العالم الذي كان يُثير حنقك لعدم فهمه سياقك السوري، ومن أين جاء كل هذا الحزن والقسوة. كصحفي، ستشهرُها أمام عيونهم مرات ومرات ليعرفوا أي جحيم كان جاثماً فوق أنفاسنا، كما ستعذّب بها نفسك على نجاتك، وعدم انضمامك لمن ذهب فداءً للحرية.
في ظل هذا الثقل كنا قد حلُمنا أن تكون لحظة التحرير أيضاً لحظة تحرُّر من الخوف والظلم الذي عشناه، وعاشه أهلنا من قبلنا. حلُمنا بأن تجد العائلات مفقوديها، وبأن تطمئن القلوب. لكن ما حصلنا عليه كان أرضاً نخاف أن نمشي عليها، ثم نعود لننبشها بحثاً عن أمل، أملٍ في العثور عليهم، أو على أجسادهم.
* * * * *
في اليوم التالي لسقوط الأسد، جرّبت لأول مرة أن أعمل بهويتي الصريحة وباسمي الكامل في مجالي الصحفي داخل سوريا، بعد تسع سنواتٍ من العمل في الخفاء مع مؤسسات ومنصات صحفية، غيّرت اسمي خلالها مرّات عديدة. اندفعتُ بكل قوتي إلى العمل مع فريق إحدى المؤسسات الإعلامية الكبيرة التي تواصلت معي قبل عدة أيام، وعرَضَت عليّ العمل كمراسلة لتغطية الأحداث. حين التقيتُ بهم صباحاً، كانت لديهم عدة اقتراحات للبدء، لكنني كنت مصرة أن الأهم هو محاولة فهم ما يجري في سجن صيدنايا، ونقل القصص عن قرب، وشرح الواقع كما هو، دون الانجراف وراء الترند الذي خلقه عدد من المؤثرين بفيديوهات وروايات عن سجون تحت الأرض وطبقات لا تنتهي.
وصلنا إلى السجن صباح اليوم التاسع من كانون الأول (ديسمبر)، لنرى المئات يسيرون باتجاهه. كانت السيارات عاجزة عن الوصول إلى المكان بسبب الحشود الضخمة، لذا تحتّم على الناس النزول والمشي ساعة كاملة تقريباً على طريق معبد يتجه صعوداً، وعند الثلث الأخير منه، يظهر السجن على قمة الجبل الذي لا بدّ من صعوده للوصول. شاهدنا عائلات كاملة تمشي، أمهات وآباء كبار في السن، وبعضهم يعاني من الأمراض والآلام، كلهم يصعدون نحو أملٍ يخبئه ذلك المكان المتوحش. كان حجاً غير مأمولة عقباه.
على الجهة الأخرى من الطريق، سار العائدون بخطوات مثقلة، أولئك الذين لم يجدوا مفقوديهم. نساء ورجال، شباب وشابات، يحاولون ثني المتجهين نحو السجن عن متابعة الطريق، ينصحونهم بالعودة، قائلين إنهم جربوا ولم يجدوا شيئاً، لكن كلماتهم لم تجد صداها، فالأهالي كانوا مستعدين للسير أميالاً أخرى، والحفر بأيديهم إن لزم الأمر، علّهم يعثرون على أثر لأحبابهم، على أي خيط يربطهم بالمفقودين.
وصلنا وكان المكان مكتظاً بالناس، متراصين جانب بعضهم، يجولون بين الغرف، يضعون آذانهم على الأرض، يبحثون في الزنزانات عن أي شيء قد يدلهم على مفقوديهم. شباب الهيئة والدفاع المدني كانوا يحفرون الأرض في أماكن متفرقة بأدوات بسيطة، فيما تعمل حفارة كبيرة في الخارج. احتشد الناس حولهم بالعشرات، يراقبون بلهفة، يتوقف الحفر حيناً، يرجوهم العاملون أن يبتعدوا، لكن لا أحد يتحرك. لم يكن أحد ليُجازف بالتراجع خطوة واحدة، فقد يخرج أحد المفقودين في أي لحظة، وكانوا يريدون أن يكونوا أول من يراه.
تكررت المشاهد ذاتها: يصرخ أحدهم «الله أكبر»، فتندفع الحشود نحوه، تتدافع، يحدوها الأمل بأنه عثر على شيء… لكن لا شيء.
بقينا هناك نحو أربع ساعات، نتحدث مع العائلات، نوثق تفاصيل المكان، نصوّر الزنزانات، بقايا الطعام المتروك، البطانيات الملقاة على عجل، تلك الرمادية المقيتة التي تحمل ملامح العسكر، والمساعدات، والممتلئة بأشباح القهر والوحشة.
عدتُ إلى المنزل مساءً، زحفتُ نحو السرير، وبدأت بكاءً مستمراً، رجفاناً يهزني، أتوقف لالتقاط أنفاسي، ثم أعود إليه كأنني أريد أن أفرغ كل شيء دفعة واحدة.
نعم، كنا نعرف. كنا ندرك تماماً وحشية هذا النظام، عشنا الاضطهاد بأشكال مختلفة وتعرض كل منا لنصيبه، سمعنا الشهادات من أقرب الناس إلينا، تابعنا التفاصيل عبر الشاشات وقرأنا عنها، لكن لحظة التكشّف هذه كانت شيئاً آخر. كانت لحظة خالصة من الحزن والغضب، لحظة قهر لم يعد يُهمس بها في السر، أو في الحلقات المغلقة لمن كان منا يعيش في سوريا، بل خَرَجت للعلن. لأول مرة، بكينا بلا خوف، تحدثنا عن الوحشية الأسدية في كل مكان بسوريا… كانت لحظة بكاء جماعية.
في اليوم الثالث بعد التحرير، ومنذ الصباح الباكر، علمنا باكتشاف الجثث في مشفى حرستا. تنقّلنا بين ثلاثة مستشفيات بعد تتبع المعلومات المنشورة، والتي كان معظمها غير دقيق. كان الناس يتوافدون بأعداد كبيرة إلى المستشفيات ذاتها، بحثاً عن أحبائهم، حتى وصلنا أخيراً إلى الوجهة التي نُقلت إليها الجثث، مشفى المجتهد. عند وصولنا، كان عدد قليل من الناس قد بدأ يعرف المكان، مما أتاح الفرصة لطرح بعض الأسئلة على الأطباء. دخلنا المشرحة بناءً على طلبهم، لم أستطع النظر، أدرتُ وجهي إلى الحائط، وبدأنا في طرح بعض الأسئلة وتسجيل الإجابات، في محاولة لفهم الطريقة التي ماتوا بها والمدة التي مرّت على وفاتهم.
كان سوء التغذية والتعذيب المستمر، إلى جانب البرد والرطوبة، من الأسباب الرئيسية لتوقف قلوبهم ووفاتهم. ملامح الأجساد، ووفقاً لما لمحته في تلك النظرات السريعة، وما أكده الأطباء، كانوا دليلاً على ذلك.
في الأيام التالية للتغطية، أصبح من الصعب عليّ أن أمارس عملي الصحفي، أو أن أكبح دموعي ورجفاني في الأماكن العامة، خاصة بعد النزول إلى أقبية معتقلات الفروع الأمنية. تلك الأقبية التي تحمل سمات مشتركة: رائحة واخزة قادرة وحدها على بث الرعب فيك، سواد كالح أو رمادي، قذارة تملأ المكان، وكتابات محفورة على الجدران تفيضُ بالرجاء والدعاء لله، ومناجاة للأمهات واستغاثات لا تنقطع، وأمل معلّق بنهاية ما.
كانت المكاتب وغرف الحراس تتوزع في أغلب الأفرع الأمنية بالطوابق العلوية، بينما كانت السجون في الأقبية. تنزلُ أولى درجات السلالم وكأنك تدخل فوهة مظلمة، حيث تختفي الرؤية تماماً. كانت الحيطان كلها سوداء أو مائلة للرمادي الغامق، والسلالم ضيقة بشكل غير متوقع، لا تعكس المساحة التي ستكتشفها لاحقاً.
نضيء هواتفنا ونتحسس خطواتنا، فكل الأفرع الأمنية تشبه المتاهات، لا شكل واضح لها ولا تحديد للمسار. لا تعرف من أين دخلت وكم من الوقت سيمضي حتى تصل إلى آخر الغرف. كان الطعام قد تُرك في المكان على عجل، فترى بضع حبات بندورة متعفنة وربطات خبز الدولة وبعض حبات الزيتون. الطعام الذي شاهدناه يكفي لحوالي عشرة إلى خمسة عشرة شخص، وذلك في الزنازين الكبيرة نسبياً، التي قال لنا أحد المعتقلين إنهم كانوا يحشرون فيها حوالي 70 شخصاً، وفي بعض الزنازين قدّ يصل العدد إلى 100 شخص.
الزنازين المنفردة قلّما وجدنا فيها طعاماً، فمعظمها كانت فارغة إلا من بطانية واحدة وبعض الشقف. لكنها كانت ممتلئة بالكلمات والرسومات. في فرع الخطيب، كانت المنفردات ملونة بأربعة ألوان لا أدري سببها: الأحمر، الأسود، الأصفر، والرمادي. اشتدت غزارة الكتابات في المنفردات ذات اللونين الأحمر والأسود، وكانت معظمها مناجاة لله بالفرج ورفع الظلم.
يوماً بعد يوم، بدأت أفقد تركيزي وقدرتي على التحكم بمشاعري، وبما أنني لم أستطع السيطرة على شيء، لا على تفاعل جسدي ولا على مخيلتي، فقد حوّلت جهودي لمحاولة التواصل مع أصدقائي ليقوموا بدورهم بالتواصل مع المنظمات التي كانت تعمل في التوثيق، لإخبارهم بحجم الملفات الموجودة والمنتشرة على الأرض، وحثهم على القدوم أو تشكيل فريق في دمشق بشكل سريع. بالطبع، كانت محاولاتي غير مجدية فعلياً، فقد كان هناك عوائق وهم كانوا يعملون على ذلك بالفعل دون الحاجة للتحفيز. لكن هذا هو ما حاولت فعله إلى جانب العمل الصحفي، الذي كنت أشعر أحياناً أنه غير مجدي في بعض المواقف.
من أكثر أقبية الفروع رعباً كان فرع 248. السواد حالك والمساحة كبيرة جداً وغير متوقعة، تنتقل فيه من ردهة بناء عادي الحجم نسبياً، لتنزل إلى قبو كبير جداً. حاولت عدّ الزنازين لكن لم أفلح، ولم أستطع التركيز على العمل والتوثيق أو الأسئلة، فقد كان هناك شيء يلح عليّ بشكل غير منطقي، وهو أن أحد الضباط أو العناصر ما زال هناك، وسيخرج من إحدى هذه الغرف ليحبسنا ويضربنا أو يقتلنا.
لم أستطع في تلك اللحظات أن أفكر غير ذلك، كنت مقتنعة أن أحدهم لم ينجح في الهرب، لم أستطع إجبار نفسي على تصديق أنهم رحلوا، وهذا ما كنا نحاول إقناع أنفسنا به كل يوم. في قلب هذا الظلام والرائحة، انتقل خوفي إلى الفريق الذي أعمل معه بعد أن شاركتهم ما أفكر فيه. المشكلة أننا كسوريين، من الطبيعي أن تراودنا هذه الخيالات، لكنني كنت قد نقلت الخوف من الصورة التي أفكر فيها إلى الفريق، وفي لحظة، تحركت إحدى البطانيات أمام الصحفية التي كانت معي، فصرخت، وصرخت معها. كانت فأرة هربت مسرعة، لكن ذلك لم يعد مهماً، قررنا الخروج، فلم نكن مفيدين ولم نستطع يومها الاستمرار والعمل كما يلزم.
انتفى موضوع النوم تقريباً، ولم أعد أحاول إجبار نفسي على القيام بذلك، فقد كانت مهمة خاسرة. رضيتُ بأنني سأعمل يومين دون نوم، وفي الثالث سأنهار وأغفو، ولا أظن أن وضعي كان مختلفاً عن العديد من الأصدقاء والصديقات الصحفيين وغيرهم. لم يعن هذا أننا لم نذهب إلى بعض السهرات والمقاهي، وتمايلنا وغنينا وشربنا بصحة سقوطه، لكن غالبيتنا، في وحدتنا، جافانا النوم وتركنا مع حمل ثقيل، وكنا نعتمد على وسائل مختلفة لتهدئة الحال.
لم أستطع أن أكون حيادية أو مهنية حول ما كنت أشاهده وأسمعه. أنا سورية، وما كنت أراه هو تركة من العفونة والحزن والخوف، أُلقيت علينا دفعة واحدة، حضَرت بتأني وحقارة على كافة الأصعدة. كنت أنظر إلى كل الاتجاهات وأرى تلك التركة جاثمة، تركة عائلة وأتباع الأسد والبعث المقرفة.
المفارقة التي فكرت فيها مراراً هي محاولتهم الناجحة لفرض وجودهم البصري القسري على الجميع. فتماثيلهم وصورهم لم تكن مجرد دعايات أو رموز سياسية، بل تحولت ضمن منهجهم في إدارة البلاد والعباد إلى مقدسات، تنظر لك في الشارع وعلى العملة، في المكاتب ودوائر الدولة، على الجبال وعند الحدود، كان الموضوع يشبه طقساً قهرياً لعبادتهم. لذا كان من الطبيعي أن تكون ردة التحرير هي تكسير الطاغية المقدس، وكانت سرعة اجتثاثه من الساحات والمباني والشوارع أيضاً صادمة.
ذهب المراقب، والراقوب، والعين المفتوحة دائماً التي تذكرنا بمكاننا ومن نحن تحت سلطتهم، لكن تركتهم لم تذهب بعد. تركة التشبيح، وقلة النخوة والأمانة، تركة الجبن وخيانة البلاد، تركة الكره الذي زرعوه، والذي لفظناه بأشكال مختلفة. ومع ذلك، نسأل أنفسنا يومياً كسوريين: لماذا كانوا يكرهوننا؟
موقع الجمهورية
————————————–
فخ عبادة الفرد: القيادة… الدين… والسياسة/ القس د. نديم نصار
تحديث 21 أذار 2025
عبر التاريخ، كانت القيادة الكاريزمية سلاحًا ذا حدين؛ فمن ناحية، ألهمت الجماهير وحركت المجتمعات، ومن ناحية أخرى، خلقت أنظمة استبدادية عطّلت النمو المؤسسي وأبقت الشعوب رهينة الفرد القائد. هذه الظاهرة تتجلى بوضوح في السياقين الديني والسياسي، حيث تأرجحت المجتمعات بين الاستفادة من قوة القيادة وبين الوقوع في فخ تقديس الأشخاص على حساب بناء المؤسسات.
في المسيحية، شكّل يسوع المسيح نموذجًا فريدًا للقيادة؛ لم يسعَ إلى تأسيس دولة أو تنظيم سياسي، بل ركّز على رسالة روحية قائمة على المحبة والتسامح والعدل. رغم ذلك، انتشرت تعاليمه وأصبحت الكنيسة لاحقًا مؤسسة ضخمة لعبت دورًا محوريًا في تشكيل التاريخ الأوروبي، لكنها لم تسلم من الانقسامات والصراعات. فقد أدى الانقسام الكبير في القرن الحادي عشر إلى انشقاق بين الكنيسة الكاثوليكية في الغرب والأرثوذكسية في الشرق، ثم جاءت حركة الإصلاح البروتستانتي في القرن السابع عشر لتعمّق الخلافات، مما أشعل حروبًا طائفية مدمرة.
التعاليم المسيحية تركز على نموذج القيادة الذي قدمه يسوع، والذي كان قائمًا على الخدمة والتواضع والمحبة، رافضًا السلطة الدنيوية وساعيًا إلى بناء مجتمع يقوم على العدل والمغفرة. لكن مع مرور الزمن، استغلت الكنيسة هذه المبادئ وتحالفت مع السلطة السياسية في أوروبا، مما أدى إلى دعمها لحروب دموية ارهقت أوروبا لقرون. لم تكن هذه الحروب المحمومة تخلو من دوافع اقتصادية واستغلالية. فشلت الكنيسة في هذا التحالف ولم تستطع المصالحة بين القيم التي دعا إليها المسيح والأجندات السياسية الفاسدة للمؤسسات السياسية الديكتاتورية. فقد أدى الوعي الديني والسياسي إلى فصل الدين عن الدولة وهذه كانت أول خطوات أوروبا إلى النظام الديمقراطي العلماني. في المقابل، يكشف التاريخ الإسلامي عن صراع دائم بين السلطة الكاريزمية للخلفاء وبُنى الحكم التي لم تستطع الاستمرار دون الاعتماد على سلطة الفرد الواحد، وهو ما أدى إلى اضطرابات سياسية ودينية متكررة. فالسلالات الحاكمة كثيرًا ما أبادت بعضها البعض في صراعات دامية على الحكم. في النهاية، كان الفشل مصير التجربتين، سواء عبر مؤسسات دينية تحولت إلى أدوات فساد واستغلال، أو عبر قادة فرديين احتكروا السلطة وأجهضوا أي محاولة لبناء نظم حكم عادلة ومستدامة.
على عكس يسوع، اتخذ النبي محمد نهجًا مختلفًا، حيث لعب دورًا سياسيًا واجتماعياً إلى جانب دوره الديني، خاصة بعد الهجرة إلى المدينة. تحول الإسلام سريعًا إلى كيان سياسي بعد وفاته، لكن غياب هيكلة مؤسسية دائمة جعل السلطة تتأرجح بين قادة كاريزميين دون إطار قانوني يحكم الانتقال السلمي للسلطة. الخلافة، التي قامت على مبدأ التوأمة بين الدين والسياسة، لم تكن قادرة على تحقيق الاستقرار، حيث اندلعت صراعات دموية حول القيادة، شملت اغتيالات حتى داخل الدائرة المقربة من النبي، مثل الحسن والحسين وعلي وعثمان. من بين هؤلاء، كان لعلي والحسين أثر عميق ومستمر حتى اليوم، حيث لا يزال إرثهما مؤثرًا في الانقسامات المذهبية والسياسية داخل العالم الإسلامي.
لم يتمكن الإسلام السياسي في العصر الحديث من تطوير آلية ديمقراطية قائمة على الشورى، بل بقي يتأرجح بين تيارين رئيسيين: التيار السلفي التكفيري الذي يقصي كل من يختلف معه، والتيار المدني الذي لم ينجح في بناء مؤسسات سياسية مستقرة تحترم التعددية. لا يزال السؤال مطروحًا: هل يمكن للإسلام أن يتكيف مع الديمقراطية كما فعلت المسيحية بعد فصل الكنيسة عن السلطة السياسية؟ التجربة الغربية في بناء النظم الديمقراطية اعتمدت على تقليص نفوذ الدين في الحكم، وهو ما لم يحدث في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، مما جعلها تعاني من عدم الاستقرار السياسي المزمن.
في العصر الحديث، شهد الشرق الأوسط عودة قوية للقيادة الكاريزمية المطلقة، حيث برزت شخصيات مثل جمال عبد الناصر، الذي رغم شعبيته الكبيرة، قاد مصر إلى هزائم سياسية وعسكرية كارثية. ثم جاء حافظ الأسد وصدام حسين، اللذان اعتمدا على الخطاب القومي الشعبوي لترسيخ أنظمة قمعية طائفية قائمة على البطش والترهيب.
حافظ الأسد، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، أسس نظامًا سلطويًا استمر لعقود، مستخدمًا شعارات مثل «الصمود والتصدي» لتبرير حكمه، بينما قام بترسيخ ثقافة الفساد والمحسوبية. في العراق، تبنى صدام حسين نموذجًا مشابهًا، حيث حكم بقبضة حديدية تحت ستار القومية العربية، لكنه في النهاية جرّ العراق إلى سلسلة من الحروب الكارثية التي دمرت البلاد وأدت إلى انهيار نظامه.
في السنوات الأخيرة، قدمت «الدولة الإسلامية في العراق و بلاد الشام» نموذجًا متطرفًا لكيفية استغلال القيادة الكاريزمية في غياب مؤسسات الدولة الحقيقية. تمكن أبو بكر البغدادي من إعلان “خلافة” وهمية جذبت آلاف المقاتلين عبر خطاب ديني متشدد استغل الانقسامات الطائفية والصراعات الأهلية. لكن يبقى السؤال المحوري: من الذي أنشأ داعش؟ ومن الذي موّلها وسلّحها بهذا الزخم الهائل من الأسلحة المتطورة؟
عندما تتمحور المجتمعات حول شخصيات قيادية فردية بدلامن بناء مؤسسات مستقرة، تصبح أكثر عرضة للاستبداد والانقسامات العميقة. في سوريا، على مدى عقود، روج نظام الأسد الأب والابن لشعارات مثل “الوحدة والحرية والاشتراكية”، لكن هذه الكلمات ظلت فارغة من أي معنى حقيقي، إذ لم يُسمح لأحد بالتساؤل عن جوهرها. واليوم، تواجه سوريا أخطر امتحان في تاريخها؛ فإما أن تتجه نحو بناء دولة ديمقراطية قائمة على القانون والمحاسبة، أو تعود إلى حكم الفرد المطلق بكل ما يحمله من قمع وفساد واستبداد.
المجتمعات في الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى الانتقال من نموذج القيادة الفردية المطلقة إلى نظم حكم قائمة على المؤسسات الشفافة والديمقراطية. لا يمكن تحقيق الاستقرار إلا عبر بناء دول تستند إلى القانون والعدالة، وليس إلى الولاء الأعمى للزعماء. على الشعب السوري إن أراد أن يطوي صفحة النظام الديكتاتوري الى الأبد، وسائر شعوب المنطقة، أن يدرك أن التغيير الحقيقي لا يكون عبر تبديل قائد بآخر، ولا بالحقد على مكون محدد من المجتمع وسلسلة من أعمال الثأر الدموي، بل عبر تغيير جذري في طريقة الحكم، بحيث لا يكون مصير الأمة مرهونًا برغبات شخص واحد ولا بفصائل مسلحة عقائدية تعيد الدين إلى السيطرة على مقدرات البلاد اعتماداً على مبدأ فائض القوة.
الدرس المستفاد من التاريخ واضح: الدول التي تعتمد على الكاريزما الفردية دون مؤسسات متينة مصيرها الفوضى والانهيار. المجتمعات التي تريد مستقبلامستقرًا عليها أن تبني مؤسسات تحميها من استبداد الأفراد، سواء كانوا زعماء دينيين أو سياسيين. لا خلاص إلا في دولة القانون، حيث لا يصبح القائد فوق المساءلة، ولا تتحول الشعارات إلى غطاء للفساد والاستبداد.
مدير مؤسسة «وعي» ـ المملكة المتحدة
القدس العربي
—————————–
كيف أوصل الشرع «هيئة تحرير الشام» إلى قصر الشعب؟/ سلطان الكنج
براغماتي إلى أبعد الحدود… وفصيله أشبه بـ«كلية عسكرية»
19 مارس 2025 م
منذ تحول الثورة السورية إلى العمل العسكري بعدما استبعد النظام السابق خيار التفاوض واستخدم القوة المفرطة في قمع المظاهرات عام 2011، شهدت البلاد طفرة في الفصائل المسلحة التي ترواحت بين إسلامية جهادية وأخرى معتدلة، بحسب موقعها من طيف التشدد والتدين الذي شكل قاعدتها المشتركة.
وفي أواخر عام 2011 تأسست إحدى أكبر الفصائل باسم «حركة أحرار الشام»، وتجمع بين الجهادية والإخوانية بأجندات محلية. ويمكن القول إن «أحرار الشام» هي أول فصيل دمج بين الجهادية والمحلية، سابقة بذلك «هيئة تحرير الشام» نفسها التي كانت تؤمن بالجهادية العالمية إبّان تبعيتها لتنظيم «القاعدة» وحتى لحظة فك ارتباطها به في يوليو (تموز) 2016.
وبمراحل تحولها وصعودها كافة، التي بلغت أخيراً بمعركة «ردع العدوان» وأوصلت «هيئة تحرير الشام» وقائدها «أبو محمد الجولاني»/ أحمد الشرع إلى حكم سوريا الجديدة، تميزت الهيئة بهيكلية داخلية دقيقة أقرب إلى «كلية عسكرية» بحسب وصف أحد القياديين السابقين في «الهيئة»، الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».
«أحرار الشام»
في البدايات كان فصيل «أحرار الشام» أكثر الفصائل السورية أدلجة وتنظيماً معاً، وكان لقادته أمثال حسان عبود وأبو يزن الشامي كاريزما قوية وثقل في الأوساط الثورية، فكانت إلى جانب أسماء أخرى كعبد القادر الصالح (قائد لواء التوحيد) شخصيات وازنة في الأوساط الثورية بمختلف مشاربها.
وبقي هذا حال الحركة حتى يوم 9 سبتمبر (أيلول) 2014. حين قتل قادتها في تفجير استهدف اجتماعاً لمجلس شورى الحركة في بلدة رام حمدان بريف إدلب. وهو تفجير لا تزال ملابساته غامضة حتى اليوم، أودى بحياة قائد الحركة أبو عبد الله الحموي (حسان عبود) ونحو أربعين آخرين من القياديين والشرعيين، لتبدأ مرحلة التراجع التدريجي في القوة والنفوذ وتصل سريعاً إلى أدنى مستوياتها فتتحول فصيلاً صغيراً موزع الولاءات بين فصائل أكبر كـ«الجيش الوطني» و«هيئة تحرير الشام».
ويذكر أن «الجيش الوطني السوري» فصيل تشكل في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2017، من 36 فصيلاً مسلحاً مثل «الجبهة الشامية»، و«جيش الإسلام»، و«فيلق المجد»، و«الفرقة 51»، و«لواء السلام»، و«فرقة السلطان شاه» المكونة بشكل أساسي من التركمان.
«لواء التوحيد»
من الفصائل الكبرى في سوريا، التي تميّزت بالقوة والنفوذ وقبول شعبي واسع أكثر من «جبهة النصرة»، «لواء التوحيد» الذي تأسس في 21 يوليو (تموز) 2012 وضمّ مجموعة من الكتائب العسكرية المحلية للقتال في مناطق ريف حلب الشمالي.
ويعد «لواء التوحيد» التشكيل الأكبر في المعارضة المسلحة في تلك المرحلة والممثل الأبرز للتيار الإسلامي «المعتدل» الذي يزاوج بين السلفية المعتدلة والإخوانية والخطاب «الوطني» المحلي. إنه أحد أكثر الفصائل التي ضمت في بداياتها أطيافاً متنوعة من الجهادي المعتدل إلى الإخواني إلى ما تعارف على تسميته «الإسلامي الوطني» أو حتى «الوطني الصرف» بمعنى غير الإسلامي؛ ما يعكس واقع التذبذب في توجهات تلك الفصائل فكرياً وآيديولوجياً.
وكان «لواء التوحيد» أبرز فصائل الثورة السورية التي خاضت معارك كثيرة وعلى جبهات مختلفة، لعل أهمها المعارك مع «حزب الله» اللبناني في بلدة القصير عام 2013. لكن بعد مقتل قائده عبد القادر الصالح في استهداف مباشر بغارة جوية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013، سرعان ما اضمحل هذا الفصيل أيضاً وتفكك، وتوزعت قياداته وعناصره بين فصائل مختلفة كل بحسب توجهه.
«جيش الإسلام»
من الفصائل البارزة التي لعبت أدواراً أساسية، «جيش الإسلام» الذي يتخذ من بلدة دوما في ريف دمشق معقلاً له، وفرض سيطرته على غالبية الحواضن الثائرة المحيطة بالعاصمة من الغوطة الشرقية في ريف دمشق وبلدة القلمون ومحيطها وصولاً إلى الحدود اللبنانية. كذلك سيطر «جيش الإسلام» على أحياء داخل العاصمة وأطرافها الشرقية، أهمها القابون وبرزة البلد وجوبر وزملكا وغيرها، وصولاً إلى ساحة العباسيين، أهم الساحات الدمشقية بعد ساحة الأمويين.
يشكّل «جيش الإسلام» بتوجهه «السلفي الجهادي» المعلن من عشرات المجموعات المسلحة العاملة في العاصمة وريفها صيف عام 2013 حتى بلغ عدده أكثر من 25 ألف مقاتل بتجهيزات عسكرية متوسطة وثقيلة، بينها دبابات وعجلات مدرعة وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ظهرت في الاستعراض العسكري الذي نظمه «جيش الإسلام» ربيع عام 2015 لدى تخريج دفعة من مقاتليه بلغت 1700 مقاتل.
وعلى رغم توجهه السلفي الجهادي، فقد دخل هذا الفصيل في جولات قتال مع «جبهة النصرة» و«فيلق الرحمن» المقرب منها، وكذلك تنظيم الدولة (داعش)؛ ما أدى إلى إضعافه بشكل كبير. لكنه بقي متماسكاً إلى حد كبير في بنيته العسكرية حتى لحظة مقتل زعيمه زهران علوش في غارة جوية يُعتقد أنها روسية نفذت في 26 ديسمبر 2015.
وكغيره من الفصائل التي تفككت بمقتل قائدها، لم يستطع «جيش الإسلام» الصمود طويلاً على رغم ما كان يتلقاه من دعم، ولم يتمكن من الحفاظ على مناطق سيطرته ونفوذه السابقة مقارنة بـ«هيئة تحرير الشام».
وبذلك تلاشى واضمحل كأغلبية فصائل الثورة السورية التي فاقت «هيئة تحرير الشام» عدداً وتلقت دعماً مادياً وإعلامياً وشعبياً، التي كانت تحمل اسم «جبهة النصرة» حينها، التي كانت مصنفة – ولا تزال – على قوائم الإرهاب العالمية؛ ما ساهم أيضاً في عزلتها حتى على الإعلام العالمي، على عكس بقية الفصائل. لكن، هذه العزلة هي نفسها التي ستتيح للتنظيم رص صفوفه وتقوية عوده بعيداً عن الأضواء والتأثيرات الخارجية.
التحدّي والصمود
في حين انشغل قادة معظم فصائل المعارضة المسلحة التي تزامن صعودها مع صعود جبهة النصرة كمثل «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» و«لواء التوحيد»، بالتنافس فيما بينهم على النفوذ في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات نظام بشار الأسد، ومحاولاتهم حصد الشعبية في الأوساط الثورية والحواضن الاجتماعية، كان قائد «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) يعمل بصمت بعيداً عن الضوضاء ولم يظهر للعلن حتى عام 2016، عندما أعلن فك ارتباطه بتنظيم «القاعدة»، ثم عاد وانكفأ إلى حد بعيد.
تشكلت «هيئة تحرير الشام» (أو جبهة النصرة سابقاً) من تحالف طوعي أو قسري لعدد من الفصائل والتنظيمات المسلحة، كـ«جبهة أنصار الدين» و«حركة نور الدين الزنكي» و«جيش السنة» و«لواء الحق» وغيرها، وتحالف طيف واسع من التشكيلات الأصغر المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وأبرزها «إمارة القوقاز» و«الحزب الإسلامي التركستاني» و«جيش العزة» و«جيش النصر»، وشهدت هي الأخرى تحولات مهمة وانشقاقات وانتقالات بين التشكيلات العسكرية. لكن ما ميّز «هيئة تحرير الشام» عن الفصائل والمجموعات الأخرى، قدرتها على تغيير مرجعيتها الفكرية وفق ما تفرضه معطيات الواقع المحلي والإقليمي والدولي، ومعطيات خريطة النفوذ والتحالفات في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد.
والواقع أنه قبل انشقاقها عن تنظيم «داعش» في ربيع عام 2013، كانت «جبهة النصرة» الفصيل الأقوى في محافظة دير الزور من حيث القدرات القتالية بأعداد تتعدى 7 آلاف مقاتل، بحسب التقديرات، وأسلحة متوسطة وثقيلة معظمها من تنظيم «داعش» في العراق. وأدى الانشقاق هذا إلى تراجعها مؤقتاً، لكنها سرعان ما أعادت ترتيب صفوفها وتمكنت من تجاوز مرحلة الضعف التي رافقت نهاية قتالها مع «داعش» الذي انتزع منها السيطرة على محافظة دير الزور وبلدة الشحيل، معقلها الرئيس، وأخرجها من معادلة التوازنات في المحافظة كلها.
لكن «جبهة النصرة» التي انسحب مقاتلوها من دير الزور إلى محافظة إدلب، عادت ونجحت في الانطلاق من جديد لبناء قوة فرضت نفسها بحلول نهاية معركة حلب أواخر عام 2016، وتشكيل «هيئة تحرير الشام» في فبراير (شباط) 2017.
وخلافاً للفصائل التي اضطرت للاندماج مع غيرها لضمان بقائها، مثل حركة «أحرار الشام» على سبيل المثال التي اندمجت مع «حركة نور الدين الزنكي» تحت مسمى «جبهة تحرير سورية»، تمكنت «تحرير الشام» من الحفاظ على استقلالها التنظيمي.
بل أكثر من ذلك، انضمت إليها بعض الفصائل الصغيرة مثل «جبهة أنصار الدين» و«جيش النصر» وهما من التنظيمات المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، أو القريبة منه، وغيرهما.
وكلما مرّ الوقت، ازدادت «تحرير الشام» نفوذاً وقوة، إلى أن تمكنت مطلع 2019 بعد موجة من القتال مع «حركة أحرار الشام» و«حركة نور الدين زنكي» وفصائل أخرى من إحكام سيطرتها على كامل محافظة إدلب، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
قائد يعرف جنوده
يقول سامي محمد، وهو قيادي شرعي ثم عسكري سابق في «تحرير الشام»، لـ«الشرق الأوسط»: «أهم عامل في بقاء واستمرارية (تحرير الشام) هو استقلالية القرار، وكاريزما القيادة التي يتمتع بها أحمد الشرع وقادة (تحرير الشام)، وتأثيرهم المباشر على عناصرهم، بالإضافة إلى الانضباط العالي والتزام العناصر والقادة بقرارات القيادة».
ولفت محمد إلى الأمر الآخر والمهم جداً هو الثقة التي بناها أحمد الشرع مع العناصر والقادة، فهو يعرف كل قادة الصفوف كلهم حتى الصغيرة ويلتقي بهم وبالعناصر بشكل دائم، وهذا عزز الثقة ومكانته بينهم وداخل التنظيم، بعكس حال الفصائل التي تتسم بالفوضوية والارتجال في القرارات».
وبحسب محمد، فإن «هيئة تحرير الشام» هي أشبه بكلية عسكرية فعلية، بعيدة عن المناطقية سواء لجهة انتماء العناصر أو القادة، بعكس الفصائل التي كان يغلب عليها الطابع المناطقي، وأحياناً العائلي. كما أن خطاب الجماعة لم يكن مناطقياً، بل اعتمدت في سردياتها الحديث عن سوريا كاملة. وعما يقصده محمد بالكلية العسكرية، يقول: «هناك هيكلية قيادية وتنظيمية واضحة بالإضافة إلى مركزية اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات التي ترسمها القيادة عبر المجموعات، وهذا عزز كثيراً قوة (تحرير الشام) بعكس الفصائل التي ليس للقيادة المركزية قيمة حقيقية فيها؛ فكل فصيل يتكون من مجموعات محلية تعمل بشكل مستقل وتتبع الفصيل الأساسي بالاسم فقط».
الاستقلالية وتجاوز الخطوط
ويقول محمد الإبراهيم، المعروف باسم «أبو يحيى الشامي»، وكان قائداً عسكرياً في أحد الفصائل الإسلامية، والمُطّلع على تقلبات الفصائل: «إن أهم عامل من عوامل صعود (هيئة تحرير الشام) هو الاستقلالية النسبية التي تمتعت بها، وقدرتها على تجاوز الخطوط المرسومة».
ويشرح الشامي في اتصال مع «الشرق الأوسط» قوله بأن بقية الفصائل ذات التبعية المباشرة لدول معينة، التزمت بخط هذه الدول إلى حد بعيد ووقفت عند سقف محدد لها، بينما عدم تبعية «تحرير الشام» بشكل مباشر حررها من التقيد بسياسة خارجية، فكانت متحررة وقادرة على التصرف بما تمليه مصالحها المباشرة وصولاً حتى إلى تدمير بقية الفصائل.
ويلفت الشامي إلى أن «ذلك لم يكن فقط بسبب قوتها الذاتية، بل بسبب تصنيفها الدولي كياناً إرهابياً، وعدم انخراط الدول في علاقة معلنة معها على غرار فصائل أخرى». وأضاف: «هذا البعد الدولي الظاهري والقرب الخفي أتاح لها هامشاً واسعاً من الاستقلالية؛ ما جعل قدرتها على المناورة والتميز عن بقية الفصائل أكثر قابلية».
ويؤكد الشامي أن «الجولاني، في صراعاته مع فصائل الثورة، وضع كل الاعتبارات جانباً وسعى خلف مصالحه ومصالح فصيله. فكان يقاتل بكل شراسة ويحرص على التغلب. على عكس فصائل كثيرة ارتضت بأنصاف الحلول».
وأخذ الشامي على بقية الفصائل «جبنها» أحياناً في المواجهات مع «هيئة تحرير الشام»، فكانت تقبل بالحلول التي يطرحها الجولاني وتصدق في كل مرة أنه يريد الصلح بينما هو يخدعها ليضعفها ثم يفككها ثم يقضي عليها.
ويضيف الشامي: «هناك تسجيل صوتي منتشر لحسن الدغيم، (الذي كان مسؤول التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري ثم أصبح الناطق باسم لجنة الحوار الوطني في إدارة أحمد الشرع بعد سقوط النظام السابق) قال فيه صراحة إن الجولاني شخص براغماتي، يضحي بأي شيء وأي شخص من أجل الوصول إلى السلطة». وبحسب الشامي، فإن «هذه البراغماتية كانت العامل الأهم في إدارة الهيئة، والقضاء على خصومها ومنافسيها أو تحييدهم، وإعادة استيعابهم ما أدى إلى إفراغ الساحة من أي مشاريع منافسة، بحيث لم يبقَ سوى مشروع حكومة الإنقاذ، التي انتقلت لاحقاً إلى دمشق بعد التحرير».
وختم الشامي بالقول إن «خبرة الجولاني العملية اكتسبها في سوريا، فلم تكن لديه هذه القدرات سابقاً. لكنه طموح جداً، ويُجيد الاستفادة من الإنجازات كما تعلم الدروس من أخطاء (داعش) و(النصرة)».
وبطبيعة الحال، لم يكن هذا الفوز ممكناً لولا أن ساهم رجال كثيرون لا سيما الشرعيون من «جبهة النصرة» و«هيئة تحرير الشام»، وخارجهما في توطيد شرعية الجولاني ومكانته من خلال الدعاية الدينية. وأبرز هؤلاء مسؤول إدارة التواصل السياسي زيد العطار المعروف تنظيمياً بـ«أبو عائشة»، وأصبح اليوم وزيراً للخارجية (أسعد الشيباني)، والمسؤول الأمني «أبو أحمد حدود» أو أنس خطّاب الذي أصبح اليوم أيضاً مديراً للاستخبارات العامة.
النصر… نصر مشترك
ويقول القيادي السابق في الجيش الحر علاء الدين أيوب، المعروف باسم «الفاروق أبو بكر»، والذي قاد مفاوضات خروج الفصائل من حلب عام 2016: «اختلفنا سابقاً حول سلوك (جبهة النصرة) – ثم (فتح الشام) – ثم (هيئة تحرير الشام)، في تعاملها مع فصائل الجيش الحر. لكن لا يمكننا إنكار أنها كانت الأكثر تنظيماً وتدريباً من بيننا. وعملت الهيئة على تنظيم صفوفها وتدريب مقاتليها، لكن في الوقت عينه لا يمكن نسب النصر الذي تحقق أخيراً لها وحدها».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كان للنصر في عملية ردع العدوان عوامل كثيرة، منها الخارجي كالتدافع الدولي والصراع بين الدول ومنها الداخلي الشعبي والعسكري الذي انعكس في نضال عشرات الآلاف من المقاتلين في المعارك ضمن فصائل الثورة… ومع ذلك، يُحسب للهيئة تفوقها على غيرها في استغلال الفرص».
وأردف أيوب قائلاً: «نعلم جميعاً المرحلة التي سبقت سيطرة الهيئة على إدلب، والمعارك التي خاضتها ضد بقية الفصائل. ولا يمكننا إغفال أن السبب الرئيسي برأيي في سيطرة الهيئة دون غيرها كان تشرذم الفصائل، وعدم قدرتها على تقديم نموذج موحد ومتماسك».
وتابع: « طغت الأنا، وظهر أمراء حرب حولوا فصائلهم أدوات استثمار لتحقيق مكاسب شخصية مالية وسلطوية، فضعفت الفصائل والانتماء إليها. وقد عزز هذه الصورة الدعم الخارجي، وارتهان الكثير من قادة الفصائل لإملاءات الجهات الداعمة».
تشكيلات بولاءات كثيرة
أما بالنسبة للتشكيلات السياسية وأبرزها «الائتلاف الوطني السوري» الذي يمثل الجناح السياسي للمعارضة المسلّحة والمخوّل بالتفاوض قبل سقوط النظام، فقد تشكل بدعم وغطاء تركي وإقليمي ما جعل ولاءات معظم الشخصيات والمجموعات داخله مقيدة بالدول التي ساهمت في إنشائه.
وختم أيوب بقوله: «على مدار أربعة عشر عاماً من الثورة السورية، برزت قيادات كثيرة كانت تمتلك خلفيات دينية وشعبية وثورية، مثل: زهران علوش، عبد القادر الصالح قائد لواء التوحيد، وحسان عبود زعيم (أحرار الشام) معه أبو يزن الشامي، وجمال معروف زعيم فصيل (جبهة ثوار سوريا) الذي قضت عليه (تحرير الشام) عام 2014، لكنهم أبعدوا عن المشهد، سواء بالاغتيال الجسدي أو بالاغتيال المعنوي بينما كان الجولاني الأوفر حظاً في البروز بعد تخفٍّ، والنجاة ثم الفوز بفضل عوامل عدة، أهمها، تجربته السابقة في العراق، وقدراته الأمنية والعسكرية».
الشرق الأوسط»
———————————–
من الانتقال السياسي إلى إعادة الإعمار.. معهد ألماني يقيّم سيناريوهات سوريا
ربى خدام الجامع
2025.03.19
قدم معهد الشؤون الدولية والأمنية الألماني* (Stiftung Wissenschaft und Politik)، تحليلاً معمقاً للوضع في سوريا بعد مرور أكثر من ستين عاماً على الديكتاتورية وأكثر من 13 عاماً على بدء الحرب، مع التركيز على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكام الجدد للبلاد.
ويشير التقرير إلى أن سوريا تقف على مفترق طرق حاسم يتطلب معالجة قضايا معقدة تشمل الانتقال السياسي، والمصالحة الاجتماعية، وإعادة الإعمار الشاملة، والتحول الاقتصادي، وعودة اللاجئين والنازحين، بالإضافة إلى حل قضايا أمنية شائكة مثل نزع سلاح الفصائل ودمجها ومحاربة تنظيم الدولة والجماعات المسلحة الأخرى.
تحديات الحكم والسيطرة الإقليمية:
يُسلط التقرير الضوء على أن الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد الشرع لا تسيطر على كامل الأراضي السورية، حيث لا تزال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الغالبية الكردية تسيطر على شمال شرقي سوريا، بينما تواصل تركيا سيطرتها على مناطق عدة في الشمال. وفي الجنوب الغربي، تحتل إسرائيل المنطقة العازلة وهضبة الجولان وجبل الشيخ، وتقيم نقاط تفتيش في المناطق المحيطة. ويستمر التقرير في بيان أن الاشتباكات المسلحة ما تزال دائرة في الشمال والشمال الشرقي بين الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً وقسد المتحالفة مع واشنطن.
يذكر المعهد أن الحكومة المؤقتة اتخذت خطوات لتسريح معظم جيش النظام المخلوع ومحاولة حل الفصائل ودمجهم في الجيش السوري الجديد، بما في ذلك قسد وفاصائل درزية. ومع ذلك، شهدت سوريا أعمال عنف طائفية عقب تمرد فلول للأسد، مما أسفر عن مقتل المئات وأكد على وجود ما سماه “عقيدة طائفية” وعدم انضباط في القوى الأمنية الجديدة، وهو ما يهدد عملية المصالحة.
التقدم السياسي المتعثر:
يشير التقرير إلى أن الإدارة الجديدة مضت قدماً في عملية الانتقال السياسي بتنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقالياً وتأكيده على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة وطناً للجميع. وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي جمع نحو 900 سوري لوضع إطار للعملية الدستورية. وفي بداية آذار، شُكلت لجنة لصياغة دستور مؤقت، وفي 13 آذار، وقع الشرع على إعلان دستوري يمتد لخمس سنوات، يحدد الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ويطرح مبادئ فصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة وحرية التعبير. ومع ذلك، أثار الإعلان الدستوري انتقادات من مختلف الطوائف بسبب عدم تعبيره عن التنوع العرقي والديني لسوريا والإبقاء على تسمية “الجمهورية العربية السورية” وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة واشتراط أن يكون الرئيس مسلماً. ويؤكد التقرير على أن تحقيق توازن بين توقعات التنوع ومواقف الجهات الفاعلة المختلفة يمثل تحدياً كبيراً.
يُوضح التقرير أن القيادة السورية الجديدة تسعى لإعادة تموضع سوريا على المستويين الإقليمي والعالمي بهدف كسر العزلة وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار والحصول على دعم لإعادة الإعمار. وقد تواصل الشرع مع دول الخليج والدول الغربية، وهنأ ترامب على عودته إلى البيت الأبيض، معبراً عن أمله في إحلال السلام واقترح مناقشات مبكرة مع واشنطن. وفي حين حافظ على مسافة بعيدة عن إيران، أكد على أهمية العلاقات الطيبة مع روسيا وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، مؤكداً على التزام دمشق باتفاقيات وقف إطلاق النار وعزمها على حل النزاعات سلمياً، مع توقع علاقات ودية مع تركيا بشكل خاص.
مصالح الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية:
يُفصل التقرير مصالح وأولويات وممارسات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وتأثيرها على عملية الانتقال في سوريا.
تركيا: تسعى إلى محاربة سوريا لإرهاب (حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة)، والحفاظ على تنوعها العرقي والديني وإشراك جميع الأطراف في الحكم، وترغب في لعب دور فاعل في بناء سوريا قوية وموحدة بما يخدم مصالحها. تركز على مصالحها الأمنية وعرضت دعم إصلاح القطاع الأمني، وتسعى للتعاون مع سوريا والأردن والعراق لمحاربة تنظيم الدولة. كما دعت تركيا مقاتلي الفصائل السورية المتحالفة معها في الشمال للانضمام إلى الجيش السوري الجديد بهدف نزع سلاح قسد أو دمج عناصرها في الجيش السوري. وقد خلق إعلان عبد الله أوجلان عن حل تنظيمه أفقاً لتسوية بين تركيا وقسد، وتسعى تركيا لتعزيز التقارب بين قسد والمجلس الوطني الكردي. كما ترغب تركيا في لعب دور بارز في إعادة إعمار سوريا.
دول الخليج (قطر والسعودية والإمارات): يُشير التقرير إلى أن قطر قد تلعب دوراً مهماً في السياسة السورية وكانت أول دولة تزور دمشق بعد سقوط الأسد وتعهدت بدعم إعادة الإعمار. أما السعودية، فيبدو أنها منفتحة على تحقيق انفراجة وترغب في منع سوريا من الاعتماد بشكل كبير على قطر وتركيا. بينما من المحتمل أن تبقى الإمارات على هامش التطورات بسبب معارضتها لهيئة تحرير الشام، لكنها قد تجدد علاقاتها مع دمشق إذا تبين عدم وجود أساس لمخاوفها.
روسيا: غيرت سياستها من دعم نظام الأسد إلى محاولة السيطرة على الأضرار واستعادة نفوذها لتأمين مصالحها، وعرضت التعاون مع القيادة الجديدة. وقد صنفت هيئة تحرير الشام سابقاً كتنظيم إرهابي ثم وصفتها بـ”المعارضة السورية المسلحة” ثم “السلطات الجديدة”. ومع ذلك، قد تواجه روسيا صعوبة في تطبيع العلاقات بسبب مطالب دمشق بتسليم الأسد وجبر الضرر. وقد تراجعت قدرة روسيا على رسم شكل عملية الانتقال، لكنها ما تزال تحتفظ ببعض النفوذ السياسي وتأمل في أن يعوض وجودها العسكري والسياسي المتضائل تعاظم النفوذ التركي. وقد دعت روسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن وحذرت من صعود الحركة الجهادية وشبهت قتل العلويين والمسيحيين بالإبادة في رواندا، مما يدل على استعدادها لاستغلال أي توتر لمصلحتها.
إسرائيل: يهمها أمنها القومي أكثر من العملية الانتقالية أو النظام السياسي الجديد، وتشعر بالقلق إزاء الخلفية المتطرفة للحكام الجدد وتعزز النفوذ التركي. وتضغط على الولايات المتحدة لضمان سلامة القواعد الروسية وتفضل بقاء سوريا دولة لامركزية ضعيفة. كما أعلنت عزمها على الاحتفاظ بوجودها العسكري في سوريا وسعت لتمتين علاقاتها مع الطائفة الدرزية والأكراد وهددت بالتدخل العسكري دعماً للدروز.
الولايات المتحدة: لم تتضح بعد سياسة إدارة ترامب الثانية تجاه سوريا، لكنها تركز على مصالحها الأمنية والجيوسياسية وضمان عدم تحول سوريا إلى “مصدر للإرهاب الدولي” وأمن إسرائيل. وقد أثر قرار تعليق المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتاً على المخيمات ومبادرات المجتمع المدني.
إيران: خسرت نفوذها المباشر وتسعى للتواصل مع الحكومة المؤقتة، لكن دمشق لم تبد اهتماماً كبيراً بإعادة العلاقات. ومن السيناريوهات المطروحة لاحتفاظ إيران بنفوذها استغلال التوترات الطائفية أو تمتين علاقاتها مع قسد أو إعادة تعريف دورها عبر “المقاومة” المناهضة لإسرائيل وظهور جماعة “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا”.
نتائج وخيارات سياسية مقترحة من المعهد الألماني:
يُشدد التقرير على أن لألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في استقرار سوريا ويجب عليهم اقتناص الفرصة والمساهمة في ذلك بتنسيق نهجهم ضمن إطار متعدد الأطراف والتعاون مع الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج. ويدعو إلى مراقبة ودعم تطبيق إعلان حل حزب العمال الكردستاني والاتفاق بين الحكومة المؤقتة وقسد. كما يرى ضرورة العمل على تجديد التزام إسرائيل والحكومة السورية الجديدة باتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974 وتسهيل التواصل بينهما.
ويؤكد التقرير على أهمية تمهيد السبيل لزيادة المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات الأوروبية خطوة أولى ضرورية لكنها غير كافية، ويجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الضغط على واشنطن لرفع العقوبات الأميركية أو إيجاد آليات بديلة لدعم التعافي. ويشدد على ضرورة بقاء العقوبات على كبار الشخصيات التابعة للنظام السابق وهيئة تحرير الشام حتى تلتزم بشروط واضحة مثل الابتعاد عن الحركة الجهادية ومنع العنف الطائفي والتحقيق في المجازر واحترام حقوق الإنسان.
كما يحذر التقرير من الدفع نحو إعادة سريعة للاجئين السوريين ويدعو إلى تمكينهم من المساهمة في إعادة الإعمار من الخارج. ويؤكد على مسؤولية الجيش السوري الجديد في محاربة تنظيم الدولة وضرورة معالجة مشكلة السجون والمخيمات، مع تشجيع الولايات المتحدة على مواصلة دعم جهود مكافحة التنظيم.
أخيراً، يدعو التقرير ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى دعم تشكيل حكومة جامعة وصياغة دستور دائم يعكس تنوع سوريا العرقي والديني لمنع إيران من استغلال التوترات الطائفية وتحقيق مصالحة اجتماعية وسياسية في البلاد.
في الآتي ترجمة تلفزيون سوريا الكاملة للتقرير:
بعد مرور أكثر من ستين عاماً على الديكتاتورية في سوريا وأكثر من 13 عاماً على بدء الحرب التي تدخلت فيها أطراف دولية، أصبح حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات كبيرة، تتمثل بالانتقال السياسي والمصالحة الاجتماعية وإعادة الإعمار الشاملة، والتحول الاقتصادي، وإعادة اللاجئين والنازحين، إلى جانب حل قضايا أمنية شائكة تشمل نزع سلاح الفصائل ومن ثم إدماجها ضمن الهيكلية المعدلة للجيش ومحاربة تنظيم الدولة في حال عودته إلى جانب محاربة المسلحين من الموالين للأسد. وهنالك قضية أخرى تتمثل بأسلوب التعامل مع كل من مقاتلي تنظيم الدولة (وأهاليهم) المحتجزين في مخيمات ومراكز احتجاز تديرها قسد، والمقاتلين الأجانب المنضوين تحت صفوف هيئة تحرير الشام ومن والاها من الفصائل.
والأصعب من ذلك هو أن الحكومة المؤقتة التي يترأسها أحمد الشرع لا تسيطر على كامل التراب السوري، لأن قسد ذات الغالبية الكردية ماتزال تمارس سيطرتها على شمال شرقي سوريا، في حين تواصل تركيا سيطرتها على مناطق عدة في الشمال السوري. وفي جنوب غربي البلد، احتلت إسرائيل المنطقة العازلة التي أقيمت في عام 1974 وكانت في السابق تخضع لسيطرة أممية، إلى جانب احتلالها لجبل الشيخ منذ كانون الأول لعام 2024، كما أنها أقامت نقاط تفتيش لها في المناطق المحيطة بتلك الأراضي. وفي تلك الأثناء، ماتزال الاشتباكات المسلحة دائرة في الشمال وشمال شرقي سوريا ما بين الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً وقسد المتحالفة مع واشنطن في حربها ضد تنظيم الدولة.
الخطوات الأولى للعملية الانتقالية
قامت الحكومة المؤقتة بإجراءات لتسريح معظم عناصر جيش النظام البائد وحل الفصائل ثم دمجهم في الجيش السوري الجديد، وتضم تلك الفصائل قسد والفصائل الدرزية التابعة لغرفة عمليات الجنوب التي وقعت دمشق معها اتفاقيات خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار عقب حدوث أعنف أحداث طائفية في سوريا منذ سقوط النظام. إذ بعد ظهور تمرد موال للأسد ضد قوات الأمن الجديدة، قتل أكثر من ثمانمئة سوري معظمهم من الطائفة العلوية، بعضهم في اشتباكات وبعضهم الآخر في عمليات القتل الانتقامية التي أعقبتها والتي نفذت بحق من قُبض عليهم من العساكر والمدنيين، وهذه التطورات أكدت وجود عقيدة طائفية سائدة، إلى جانب عدم الالتزام بالانضباط وعدم وجود هياكل قيادة واضحة ضمن القوى الأمنية الجديدة، ما يشكل خطراً حقيقياً يهدد عملية المصالحة بين الطوائف العرقية والدينية في سوريا. وحتى قبل موجة العنف الأخيرة، ظهرت تقارير حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان نفذتها قوات الأمن الجديدة بحق أفراد من نظام الأسد المخلوع، ومعظم تلك الانتهاكات نفذت كأعمال انتقامية بحق العلويين.
مضت الإدارة الجديدة بعملية الانتقال السياسي نحو الأمام، إذ في أواخر شهر كانون الثاني من عام 2025، وبعد أن تم تنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقالياً على يد من انتصروا من الثوار، شدد هذا الرجل على ضرورة أن تصبح سوريا الجديدة وطناً لكل مواطنيها تختفي فيه كل أعمال الانتقام، وأكد على أهمية تشكيل حكومة جامعة تكفل تمثيل الجميع في مطلع شهر آذار. وفي أواسط شهر شباط، شكل الشرع لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بينهم ممثلون عن “حكومة الإنقاذ” السابقة في إدلب وعضوان من المجتمع المدني، ثم انعقد هذا المؤتمر الذي لم تسبقه فترة إشعار مناسبة، خلال الفترة ما بين 24-25 من شباط في دمشق، وجمع نحو 900 سوري من أجل وضع إطار العمل الميداني تمهيداً للمضي قدماً بالعملية الدستورية. وفي بداية شهر آذار، شكلت لجنة لصياغة دستور مؤقت، لكن الأمور لم تخضع لمداولة كبيرة، إذ بحلول الثالث عشر من آذار، وقع الشرع على إعلان دستوري يمتد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وحددت تلك الوثيقة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وطرحت مبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة أمام القانون وحرية التعبير. بيد أن مسؤولية التشريع خلال الفترة الانتقالية، ستكون بيد البرلمان الذي سيجري تعيين أعضائه (على أن يعين الرئيس وبشكل مباشر ثلث أعضائه)، أما الرئيس فيتمتع بسلطات تنفيذية وبيده أمر الإعلان عن حالة الطوارئ. كما سيجري تشكيل لجنة من أجل العدالة الانتقالية، إلى جانب لجنة لصياغة دستور دائم للبلد، وسيجري تأجيل الانتخابات حتى عام 2030. وسرعان ما أثار الإعلان الدستوري انتقادات من الطوائف في سوريا، إذ على الرغم من طرحه لمبدأ حرية الدين والمعتقد، لم يعبر عن التنوع العرقي والديني لسوريا التي احتفظت باسمها السابق (الجمهورية العربية السورية)، إلى جانب تسمية العربية وحدها كلغة رسمية للبلد، والتأكيد على وجوب أن يكون الرئيس مسلماً، ولكن لا شك بأن خلق حالة توازن بين توقعات التعبير عن التنوع بين الأغلبية والأقليات، وناشطي المجتمع المدني والعديد من الجهات الأجنبية الداعمة والفصائل المتطرفة الموجودة ضمن قاعدة القيادة الانتقالية نفسها يعتبر أمراً محفوفاً بالمخاطر والتحديات إلى أبعد الحدود.
وفي الوقت ذاته، تحرص القيادة السورية الجديدة على إعادة تموضع سوريا بعد سقوط الأسد على المستويين الإقليمي والعالمي، والهدف من ذلك كسر العزلة التي فرضت على البلد لفترة طويلة، وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار، إذ تريد سوريا الجديدة أن تتجنب تلك النظرة التي تعتبرها تهديداً على المستوى الإقليمي أو الدولي، والأولوية الأساسية في هذا السياق الحصول على الدعم من أجل إعادة إعمار البلد، ولتحقيق هذه الغاية، لم يمد الشرع يده لدول الخليج العربية فحسب، وعلى رأسها السعودية، بل للدول الغربية أيضاً، إذ هنأ دونالد ترامب على عودته الأخيرة إلى البيت الأبيض، وأعرب عن أمله بأن يعمل الرئيس الأميركي على إحلال السلام، واقترح قيام مناقشات مبكرة مع الإدارة الجديدة بواشنطن. وفي الوقت الذي احتفظ الشرع بمسافة بعيداً عن إيران، أكد مصلحته في المحافظة على علاقات طيبة مع روسيا، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، وأكد على التزام دمشق باتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة في عام 1974 وعلى عزمها على حل النزاعات مع دول الجوار بطريقة سلمية، والجميع يتوقع قيام علاقات ودية وتقارب مع تركيا على وجه الخصوص.
مصالح الجهات الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في سوريا
إن مصالح الجهات الفاعلة إقليمياً ودولياً وأولوياتها وممارساتها هي التي ستهيئ الساحة أمام حكام سوريا الجدد في تعاملهم مع التحديات التي تكتنف العملية الانتقالية بسوريا، إذ عقب سقوط نظام الأسد، عمدت بعض تلك الجهات الفاعلة الخارجية إلى تغيير موقفها، في حين أوضحت أطراف أخرى، مثل الولايات المتحدة، موقفها تماماً. بيد أن هنالك شيئاً واضحاً يهمهم جميعاً بالمقام الأول، ألا وهو المصالح القومية إلى جانب مراعاة الاعتبارات السياسية والاقتصادية الداخلية، وهذا ما يؤكد احتمال ظهور تضارب قد يعيق الجهود الساعية لتحقيق الاستقرار في سوريا.
تركيا
تشير التصريحات الرسمية الصادرة عن تركيا إلى وجود ثلاثة أهداف لديها في سوريا، أولها ضرورة عدم دعم سوريا للإرهاب (والمقصود هنا حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة) وعدم تشكيلها لأي خطر يهدد جيرانها، إلى جانب احتفاظها بتنوعها العرقي والديني وضرورة تمثيل وإشراك كل تلك الأطراف في الحكم. أي أن أنقرة تعتبر عملية نشر الاستقرار التي تقوم بها الحكومة المؤقتة الموجودة في دمشق ضرورة، وترغب في لعب دور فاعل في بناء سوريا القوية والموحدة، وبما ينسجم مع المصالح التركية الأساسية، ولهذا تسعى تركيا للانخراط في مجالين مهمين على المدى القصير والمتوسط.
أولاً: تركز تركيا على مصالحها الأمنية، ولهذا عرضت فكرة دعم عملية إصلاح القطاع الأمني في سوريا، وبحسب ما ذكره وزير الدفاع التركي يشار غولار، فإن أنقرة على استعداد لمساعدة الحكومة الانتقالية في التدريب العسكري إن لزم الأمر. وفي مطلع شهر شباط، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الشرع في أنقرة لمناقشة التعاون الوثيق في مجالات عدة، أبرزها احتمال توقيع معاهدة دفاع بينهما. كما تسعى كل من تركيا وسوريا والأردن والعراق لمحاربة تنظيم الدولة معاً، إذ عقد أول اجتماع للتباحث في هذا الشأن بالأردن في التاسع من آذار، من دون أن يعلن عن أي خريطة ملموسة للطريق في هذا الاتجاه.
في تلك الأثناء، دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، جميع مقاتلي الفصائل السورية الموجودة في شمالي سوريا والمتحالفة مع تركيا، والتي تضم أكثر من 80 ألف مقاتل إلى الانضمام إلى الجيش السوري الجديد. وهذه الدعوة تتماشى مع الاستراتيجية الأوسع لأنقرة الساعية إلى نزع سلاح قسد الذي تترأسه وحدات حماية الشعب الكردية، أو العمل على إدماج العساكر الأفراد ضمن جيش البلد الذي يخضع لقيادة دمشق بشكل كامل. كما تهدف دعوته أيضاً إلى طرد أي عناصر تركية (وغير سورية) موجودة ضمن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب من سوريا، ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت تركيا خطوات عسكرية من خلال الجيش الوطني السوري، كما استعانت بدعمها الجوي لقطع خطوط الإمداد عن قسد والموجودة في محيط عين العرب كوباني بالشمال السوري، فأضعفت بذلك القدرات القتالية لدى تلك المجموعة.
وفي الوقت ذاته، تمارس تركيا ضغطاً دبلوماسياً على قسد وحزب العمال، إذ في أواخر شباط الماضي، أعلن عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال المسجون في تركيا، عن حل تنظيمه ونزع سلاحه بكل ثقة، ما دفع بحزب العمال إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار والتصديق على ما أعلنه أوجلان والمطالبة بإطلاق سراحه. وهذا ما جعل الجهات الفاعلة الكردية في العراق، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ترحب بمبادرة أوجلان، ومن جانبه، أوضح القائد الأعلى لقسد، مظلوم عبدي، بأن حل الحزب ورمي سلاحه لا يمكن تطبيقه على قسد، لكنه أعرب عن انفتاحه على أي حل سلمي في سوريا.
خلق إعلان أوجلان أفقاً لتحقيق تسوية ما بين تركيا وقسد، وإزاء ذلك ظهر بين ثنايا إصرار أنقرة على ضرورة أن تكون سوريا شاملة وجامعة لكل الطوائف العرقية والدينية احتمال تأويل ذلك كبادرة على التفاوض من أجل تشكيل هيئة تمثيلية جديدة للكرد، إذ بالفعل، سعت تركيا منذ أمد بعيد لتعزيز التقارب بين قسد والمجلس الوطني الكردي الذي دعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، وفي مكالمة هاتفية مع عبدي، أعلن مسعود برزاني زعيم هذا الحزب عن دعمه للاتفاق الحاصل مؤخراً بين دمشق وقسد، وأكد على أهمية وحدة الكرد، كما رحب المسؤولون الأتراك بهذه الاتفاقية بحذر، وأكدوا على ضرورة تطبيقها بشكل كامل، وفي هذه الأثناء تواصلت الغارات الجوية التركية على العراق وسوريا.
أما المجال المهم الثاني الذي ترغب القيادة التركية في لعب دور بارز من خلاله فهو إعادة إعمار سوريا، إذ بعيداً عن الفرص الاقتصادية التي يرجح لشركات البناء التركية أن تقتنصها، يمكن لذلك أن يعزز شعبية أردوغان وسط حالة الضيق الاقتصادية التي تعيشها تركيا، كما أن أنقرة تعتبر إعادة إعمار سوريا شرطاً مهماً لتسهيل عودة اللاجئين السوريين.
دول الخليج
إذا نجحت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها في تعزيز موقفها، فإن قطر ستلعب دوراً مهماً في السياسة السورية هي أيضاً، إذ ليست مصادفة تلك التي جعلت من الأمير تميم بن حمد أول قائد دولة يزور دمشق بعد سقوط الأسد. ومنذ ذلك الحين، توالت زيارات المسؤولين والوفود القطرية على سوريا وذلك خلال شهري كانون الأول من عام 2024 وكانون الثاني عام 2025. وفي أواسط كانون الأول، كانت السفارة القطرية ثاني سفارة تعيد فتح أبوابها، بعد السفارة التركية، عقب تعليق العلاقات الدبلوماسية الذي نفذته دول كثيرة بين عامي 2011-2012 رداً على قمع النظام البائد للمعارضة. وتعهد رئيس وزراء قطر بدعم عملية إعادة إعمار سوريا وطالب بإنهاء العقوبات المفروضة عليها، إذ من الواضح تماماً بأن الدوحة قد وضعت نفسها في موضع أحد الوسطاء المهمين بين سوريا وأي دولة ثالثة، وستتعاظم أهمية هذا الدور في حال بقيت تلك الدول مترددة في التعامل مع الحكام الجدد لدمشق.
ثمة دولة أخرى بوسعها لعب دور مهم في المشهد الدبلوماسي السوري وهذه الدولة هي السعودية، إذ يبدو بأن هنالك مصلحة كبيرة لهيئة تحرير الشام في تعزيز علاقات طيبة مع أقوى دولة عربية، وقد ألمحت المملكة إلى انفتاحها على تحقيق انفراجة وذلك عندما أرسلت وزير خارجيتها الذي دعا على الفور إلى رفع العقوبات وقدم الدعم للحكومة الجديدة. ويبدو أن الرياض مستعدة للاعتراف بالواقع الجديد في دمشق مع التشجيع على الحوار والتعاون لإدارة النتائج المترتبة على سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة. وثمة شيء مهم لا بد أن تأخذه السعودية بالحسبان وهو منع سوريا من الاعتماد بشكل كبير على قطر وتركيا، غير أن قيام الشرع في مطلع شباط 2025 بأول زيارة خارجية له عقب سقوط الأسد إلى الرياض بدلاً من أنقرة يوحي باحتمال الابتعاد عن هذا الشكل من الاعتماد الكبير.
يحتمل للإمارات أن تبقى على هامش كل تلك التطورات نظراً لوقوفها ضد هيئة تحرير الشام ومعارضتها لها بشكل مبدئي وهذا ما يمنعها من التعامل معها مباشرة، لهذا يرجح لأبوظبي أن تراقب من كثب احتمال إثارة انتصار الإسلاميين في سوريا لمزيد من الاضطرابات في المنطقة، ولهذا لن تألو جهداً في منع وصول آثار ذلك إلى بلادها. ولكن إن تبين لها عدم وجود أصل أو أساس لمخاوفها، فإن الإمارات ستكون من بين تلك الدول التي ستحرص على تجديد علاقاتها مع دمشق.
روسيا
بما أنها كانت من أهم داعمي نظام الأسد في السابق، فقد غير الكرملين سياسته وانتقل إلى سياسة السيطرة على الأضرار مع سعيه في الوقت ذاته لاستعادة نفوذه السياسي من أجل تأمين مصالحه الأساسية في سوريا، وخاصة فيما يتصل بالاستعانة بالقواعد العسكرية الموجودة فيها، ولهذا عرضت روسيا التعاون مع القيادة الجديدة في دمشق لأنها ترغب أن تقدم نفسها كعنصر فاعل براغماتي على استعداد للتكيف مع ديناميات السلطة الجديدة. إذ حتى كانون الأول من عام 2024، بقيت موسكو تصنف هيئة تحرير الشام على أنها تنظيم إرهابي، ولكن في الثامن من كانون الأول 2024، أي في يوم سقوط الأسد، صارت تصف الهيئة بأنها “المعارضة السورية المسلحة” ثم أصبحت تصفها بـ”السلطات الجديدة”. وفي محاولة للتعامل مع الهيئة، أعلن فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة بأن التحالف الروسي مع سوريا “لا يرتبط بأي نظام”.
غير أن موسكو قد تكتشف صعوبة “تطبيع” العلاقات مع الحكومة التي تترأسها هيئة تحرير الشام، وهذا ما اتضح عندما زار نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سوريا في أواخر شهر كانون الثاني من عام 2025، إذ خلال تلك الزيارة، أوضح الشرع بأن على روسيا الاعتراف بما وصفه “أخطاءها السابقة” من أجل “إعادة بناء الثقة”، بيد أن هنالك مطلبين تقدمت بهما دمشق من المرجح أن يمثلا تهديداً حقيقياً لموسكو، خاصة في ظل ظروف الحرب المستمرة في أوكرانيا، وهذان المطلبان هما: تسليم الأسد وجبر الضرر، إذ لا أحد يتوقع أن تسلم روسيا الأسد على الإطلاق، بما أن تسليمه لا بد أن يقوض مصداقية روسيا بوصفها حامياً موثوقاً لحلفائها من المستبدين، أما فيما يتصل بالمطلب الثاني، فإن موسكو قد تعفي سوريا من قسم من ديونها الكبيرة المستحقة لروسيا، أو قد تعفيها منها كلها، أو قد تمدها بالحبوب أو النفط من دون أن تعترف رسمياً بما يُلزمها بتقديم تعويضات بهدف جبر الضرر. وفي تلك الأثناء، وفي محاولة منها لتحسين صورتها، قدمت روسيا اللجوء للسوريين الهاربين من العنف الطائفي الذي اندلع في آذار، وعرضت الاستعانة بقواعدها العسكرية كمراكز لوجستية لتوزيع المساعدات الإنسانية، ومن جانبها، ستبقى القوات المسلحة السورية معتمدة على روسيا في عمليات الصيانة وتأمين قطع التبديل في المستقبل المنظور.
لا شك أن قدرة روسيا على رسم شكل عملية الانتقال في سوريا قد تراجعت بشكل كبير، إذ لم يعد لدى روسيا حلفاء سياسيون أقوياء في سوريا، كما تراجعت إمكاناتها العسكرية على حماية هؤلاء الحلفاء، والأهم من كل ذلك أن عملية أستانا التي نسقت من خلالها روسيا وتركيا وإيران مواقعها تجاه مستقبل سوريا، لم يعد لديها أي نفوذ أو أهمية، ومع ذلك ما تزال موسكو تحتفظ ببعض النفوذ السياسي في سوريا، إذ يأمل الكرملين أن يتحول استمرار الوجود العسكري والسياسي على الرغم من تقلصه في سوريا نفسها وفي المنطقة كلها إلى مصلحة استراتيجية للحكومة الانتقالية، بما أن هذا الوجود سيقف ضد تعاظم الوجود والنفوذ التركي في سوريا. وبما أن روسيا تعتبر دولة قوية تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن وبما أنها عنصر فاعل مهم في المنتديات الدولية مثل دول البريكس+ والتجمعات الإقليمية مثل مجلس شنغهاي للتعاون، فإنه بوسع روسيا إما أن تسهم أو أن تعقد عملية تحقيق الاعتراف الدولي بالقيادة السورية الجديدة.
ونظراً لاحتمال التقارب بين روسيا والولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، ومطالبة إسرائيل بإبقاء القواعد الروسية في سوريا، والمجازر التي قامت ضد العلويين والمسيحيين في سوريا في آذار 2025، بات من الواضح أن الكرملين تعجبه الشروط التي تساعده على تعزيز موقفه ومكانة بلده، إذ إلى جانب الولايات المتحدة، دعت روسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن في منتصف شهر آذار حذر خلاله المندوب الروسي من صعود الحركة الجهادية في سوريا، وشبه قتل العلويين والمسيحيين بالإبادة التي حصلت في رواندا. ثم إن انعقاد الاجتماع خلف أبواب موصدة دليل على أن روسيا لا تريد أن تخاطر بعلاقتها التي ما تزال هشة مع القيادة الجديدة في سوريا، وفي الوقت عينه، يظهر ذلك استعداد روسيا الدائم لاستغلال أي توتر في سوريا لمصلحتها حتى تمارس الضغط عبر التلاعب ضمنياً بفكرة تأييد قيام حكم ذاتي في المنطقة الغربية من سوريا، بيد أن تصريح الشرع بأنه يرغب في الاحتفاظ بـ”علاقات استراتيجية عميقة” مع روسيا، وضرورة عدم وجود أي “شقاق بين سوريا وروسيا” يعتبر مؤشراً على نجاح سياسة الحد من الأضرار التي تنتهجها موسكو.
إسرائيل
في الوقت الذي تدعم المؤسسة السياسية الإسرائيلية عموماً “حق استقلال” الأقليات العرقية والدينية عن سوريا، ما يزال أشد ما يقلقها من جارتها هو أمنها القومي لا العملية الانتقالية ولا النظام السياسي الجديد فيها. إلا أن خلفية حكام دمشق الجدد تعتبر مصدراً للقلق بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة لتعاظم النفوذ التركي بما أن إسرائيل تعتبر تركيا عدوة، وبحسب تقارير ظهرت عبر الإعلام، فإن إسرائيل تضغط بشكل فاعل على الولايات المتحدة لضمان سلامة القواعد العسكرية الروسية الموجودة في سوريا، لأنها تفضل بقاء روسيا في وجه تركيا، كما تتمنى لسوريا أن تظل دولة لامركزية ضعيفة.
هذا ولم تكتف إسرائيل بالإعلان عن عزمها على الاحتفاظ بوجودها العسكري في سوريا في المستقبل المنظور، بل سعت أيضاً إلى تمتين علاقاتها مع الطائفة المقيمة في المنطقة الحدودية ومع الكرد أيضاً، إذ بنهاية شهر شباط عام 2025، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع كامل للمظاهر العسكرية من ثلاث محافظات سورية تقع في الجنوب، وهي القنيطرة ودرعا والسويداء، وأعلن أن إسرائيل لن تتسامح مع أي وجود للجيش السوري في تلك المناطق، وفي بداية شهر آذار، وفي ظل الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين قوات الأمن التابعين للحكام الجدد والفصائل الدرزية الموجودة في ضاحية جرمانا القريبة من دمشق، هددت إسرائيل بتدخل عسكري دعماً للطائفة الدرزية، وفي أواسط شهر شباط، سمحت لوفد مؤلف من شخصيات دينية درزية بزيارة مواقع دينية وزيارة الطائفة الدرزية المقيمة ضمن الأراضي التي تخضع لسيطرة إسرائيل وذلك لأول مرة منذ حرب عام 1973. كما عرضت إسرائيل على الدروز منحهم مساعدات وفتح فرص العمل أمامهم.
الولايات المتحدة
لم تتضح بعد ملامح المسار الذي ستسير عليه الولاية الثانية لترامب مستقبلاً فيما يخص سوريا، كما أن واشنطن لم تعتبر قيام مناقشات بشأن سوريا أولوية بالنسبة لها، ولكن السياسة الأميركية قد تتغير فجأة، وقد يؤثر ذلك بشكل خاص على الوجود العسكري الأميركي في سوريا وعلى التعاون الأميركي مع قسد، إذ تشير أولى الإرهاصات إلى أن إدارة ترامب لا تركز على “الانتقال الجامع” لأن ما يهمها هو مصالحها الأمنية والجيوسياسية، كما أن أهم أهدافها تتمثل بضمان عدم تحول سوريا إلى “مصدر للإرهاب الدولي” إلى جانب ضمان أمن إسرائيل.
وفي الوقت ذاته، ظهرت تعقيدات عقب القرار الذي أصدرته إدارة ترامب بخصوص تعليق كامل المساعدات الخارجية الأميركية بصورة مؤقتة، والتي تشمل تلك المساعدات التي تقدم للمرافق مثل مراكز الاحتجاز أو المخيمات وعلى رأسها مخيما الهول والروج حيث يحتجز مقاتلو تنظيم الدولة مع عوائلهم. وفي الوقت الذي تم التوصل فيه إلى حل مؤقت لتعويض العناصر الأمنية التي تحرس تلك المقرات، بما أن رواتبهم كانت في السابق تصلهم عبر التمويل المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإن اضطرابات حادة قد تعقب ذلك في حال قطع الحوالات إلى أجل غير مسمى. ولقد أضر تعليق المساعدات الخارجية الأميركية بعمليات المفوضية العليا للاجئين بشكل كبير في سوريا كما أضر بعدد من المبادرات الخاصة بالمجتمع المدني السوري.
إيران
مع سقوط نظام الأسد، خسرت إيران نفوذها المباشر في سوريا، وصارت تحرص اليوم على التواصل مباشرة مع الحكومة المؤقتة في دمشق، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن نهج إيران: “يقوم على سلوك الطرف الآخر”، ملمحاً إلى استعداد طهران لإحياء علاقاتها التي قطعها سقوط الأسد في حال سنحت لها الفرصة. بل حتى المرشد الأعلى، علي خامنئي، غير موقفه العدائي الذي أبداه في البداية تجاه الحكام الجدد لسوريا، فصار يركز الآن على المطالبة بـ”تحرير البلد من الاحتلال الأجنبي”، بيد أن دمشق لم تبد كبير اهتمام بإعادة العلاقات مع طهران، إذ حتى لو جرى إحياء تلك العلاقات، سيظل النفوذ الإيراني أضعف بكثير مما كان عليه من قبل، ونظراً لافتقار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الموارد الاقتصادية التي بوسعها تقديمها كحوافز مهمة، يرجح لدورها أن يبقى محدوداً في سوريا، أما جهود إعادة الإعمار فستقودها جهات فاعلة تتمتع بموارد مالية أكبر تحت تصرفها.
من السيناريوهات المنطقية المطروحة بالنسبة لاحتفاظ إيران بنفوذها ذلك السيناريو الذي يرى بأن ذلك يمكن أن يتم عبر استغلال أي توتر طائفي، إذ يرجح لطهران أن تزيد من تواصلها مع الطائفة العلوية في غربي سوريا، كما يمكن للتقارير التي تتحدث عن اعتقالات وإعدامات طالت العلويين على يد فصائل تابعة لهيئة تحرير الشام أن تغذي أنشطة خلايا المقاومة التي يمكن لإيران أن تدعمها بالسر كوسيلة لممارسة الضغط، بيد أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد وبشكل كبير على طريقة تعامل الحكام الجدد مع العدالة الانتقالية والديناميات الطائفية في سوريا.
وثمة نهج آخر مطروح وهو سعي إيران لتمتين علاقاتها مع قسد، إذ يمكن لتوقع الانسحاب الأميركي من سوريا أن يدفع قسد للبحث عن شراكات أخرى، وبحسب تقارير، فإن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني، أجرى محادثات مع قائد قسد، مظلوم عبدي، في مدينة السليمانية العراقية في مطلع كانون الثاني لعام 2025، وقد قيل إن بافل طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو من سهّل عقد ذلك الاجتماع. بيد أن عقد شراكة مع كرد سوريا لن يسمح لإيران بالاحتفاظ بنفوذها على الديناميات الداخلية لسوريا فحسب، بل بوسعه أيضاً الوقوف ضد النفوذ الإقليمي التركي مع كبح جماح العلاقات المتنامية بين إسرائيل والفصائل الكردية. غير أن الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين الحكومة التي تتزعمها هيئة تحرير الشام وقسد قد يتحول إلى مفتاح للعمل في هذا المضمار، إذ نظراً للشكوك المحيطة بتنفيذ الاتفاقية واحتمال تجدد التوتر بين القوات الكردية السورية من جهة ودمشق وأنقرة من جهة أخرى، يرجح لطهران أن تحافظ على فتح قنوات تواصل مع الكرد.
وأخيراً، قد تسعى طهران لإعادة تعريف دورها في سوريا عبر “المقاومة” المناهضة لإسرائيل، إذ بعد فترة قصيرة من الخطاب الذي ألقاه خامنئي في الثاني والعشرين من كانون الأول عام 2024، ظهرت جماعة لم تكن معروفة سابقاً، لكنها أطلقت على نفسها اليوم اسم: “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا”، وأعلنت أن هدفها هو طرد القوات الإسرائيلية من البلد، وهذا التطور قد يمد إيران بسبل جديدة للاحتفاظ بنفوذها في سوريا، إذ مثلاً، قد تعمد طهران إلى الاعتماد على قوات وكيلة جديدة أو إلى التحجج بـ”مقارعة الاحتلال” لتبرير تعاونها مع الحكومة السورية الجديدة.
نتائج وخيارات سياسية
لدى ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في تأمين عملية نشر الاستقرار في سوريا وضمان عدم تشكيل هذا البلد لأي خطر على جيرانه وعلى أوروبا، لأن سقوط نظام الأسد قدم فرصة فريدة لتحقيق تلك الأهداف، إلا أن احتمال الخطأ ما يزال كبيراً، لأن النزاعات المسلحة قد تشتعل مرة أخرى في سوريا، وبدورها سوف تشجع العناصر الفاعلة الإقليمية والدولية على التدخل عسكرياً من جديد، وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن ذلك سيطيل أمد اقتصاد الحرب والاتجار بالمخدرات، وهذا ما سيدفع لظهور موجات نزوح جديدة، وفي الوقت ذاته، ستظل سوريا ملاذاً آمناً ومقراً لتجنيد العناصر ضمن تنظيم الدولة وغيره من الجماعات الجهادية.
ولهذا ينبغي على ألمانيا والاتحاد الأوروبي اقتناص هذه الفرصة التي ظهرت اليوم للمساهمة في نشر الاستقرار بسوريا، إلى جانب تنسيق نهجها بشكل وثيق ضمن عمل إطاري متعدد الأطراف، ويعتبر التعاون ضرورياً بشكل كبير مع الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ويجب أن ينصب الهدف على وقف تصعيد الخصوم الجيوسياسيين بدلاً من العمل على تأجيج هذا التصعيد، مع دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها على اعتبار ذلك أحد المبادئ الإرشادية ضمن هذا المضمار.
إن الإعلان عن حل حزب العمال الكردستاني من جهة، والاتفاق بين الحكومة السورية المؤقتة وقسد من جهة أخرى، يعتبر فرصة لحل التوتر في الشمال السوري، ولهذا لا بد من مراقبة تطبيق هذين الأمرين من كثب مع دعم العمليتين، وذلك لأن فشل أي منهما يمكن أن ينعكس بالسلب على الأخرى. وفي هذا السياق، من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف المشاركة فيهما، وعلى رأسها رغبة الكرد في الحصول على تمثيل يناسبهم في أي حكومة سورية مستقبلاً وكذلك رغبتهم في الحصول على حكم ذاتي بصلاحيات واسعة، إلى جانب مراعاة المخاوف الأمنية التركية ومصلحة دمشق في حل الفصائل وإنهاء السيطرة التركية على أجزاء من سوريا.
كما يجب على ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي العمل على ضمان تجديد التزام كل من إسرائيل والحكومة السورية الجديدة باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة عام 1974، وهذا من شأنه أن يجبر إسرائيل على سحب قواتها من المنطقة العازلة ومن جبل الشيخ وإعادة المنطقة لسيطرة قوات مراقبة فض الاشتباك الأممية. كما بوسع برلين وغيرها من شركائها الأوروبيين وبالتشاور مع الولايات المتحدة، تسهيل التواصل بين القيادة السورية وإسرائيل للحد من خطر المواجهات العسكرية، بما أن التواصل أضحى ضرورة نظراً لانتهاء العمل بآلية التنسيق الروسية الإسرائيلية لتجنب الصراع في سوريا.
ويجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي تمهيد السبيل أمام زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار سوريا التي دمرتها الحرب بعد سنين طويلة، وإن تحقيق تحسن سريع في الوضع الاقتصادي السوري يعتبر أمراً مهماً لنشر الاستقرار في البلد، إذ في أواخر شهر كانون الثاني، اتخذ مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خطوة في الاتجاه الصحيح عندما صدّق على خريطة طريق من أجل تخفيف العقوبات بشكل تدريجي على القطاعات والمؤسسات في سوريا. وبنهاية شهر شباط، جرى تعليق بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على قطاع الطاقة والنقل والقطاع المالي، على الرغم من أنها لم تُرفع بشكل كامل، إذ تعتبر تلك الإجراءات الأولية ضرورية لكنها ليست كافية، لأن العقوبات الأميركية ما تزال تمثل عائقاً رئيسياً أمام إعادة إعمار سوريا وتعافيها على المستوى الاقتصادي، ولذلك يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يضغطا على واشنطن حتى ترفع تلك العقوبات، وفي حال بقيت تراوح مكانها، عندئذ يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الخروج بآليات قابلة للتطبيق وذلك لدعم المساعدات الإنسانية ولتمهيد الطرق أمام التعافي الأولي للبلد، كما تجب إعادة توجيه الأصول المجمدة لنظام الأسد البائد نحو جهود إعادة الإعمار.
وفي الوقت ذاته، يجب أن تبقى العقوبات المفروضة على كبار الشخصيات التابعة لنظام الأسد وهيئة تحرير الشام، وقبل إخراج الهيئة من لوائح الإرهاب في ألمانيا والاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات عمن يمثلوها، لا بد لهم من تحقيق شروط واضحة، إذ يجب على حكام دمشق الجدد أن يظهروا ابتعادهم بشكل حقيقي عن الحركة الجهادية، وذلك عبر تعزيز العلاقات الخارجية بشكل سلمي مثلاً، أو عبر منع قيام عنف على أساس طائفي، وفتح تحقيق في المجازر التي ارتكبت في آذار 2025 ومحاكمة مرتكبيها، والالتزام بإقامة عدالة انتقالية شفافة، واحترام لحقوق الإنسان.
ومن جانبهما، يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يحجما عن الدفع نحو إعادة سريعة للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا حالياً، إذ لا يكفي الالتزام بمبدأ العودة الطوعية الآمنة والكريمة، بل أيضاً يجب أن يحل في سوريا ما يكفي من الاستقرار حتى تصبح جاهزة لعودة مواطنيها. ويجب على السياسة الأوروبية أن تولي الأولوية لتمكين اللاجئين على الإسهام بطريقة بناءة ودائمة في إعادة أعمار سوريا، بما أن هذه المساهمة يمكن أن تتم من الخارج. وفي الوقت عينه، ينبغي على ألمانيا دعم مفوضية اللاجئين في تسهيل عمليات العودة الطوعية، وهنا تظهر الحاجة لظهور حل وسط ما بين مصلحة ألمانيا في نشر الاستقرار بسوريا ومصلحتها في قدرتها على ترحيل الإرهابيين والمجرمين على وجه الخصوص، إلى جانب قدرتها على ترحيل السوريين الذين لا يندرجون ضمن هاتين الفئتين.
هذا ويجب على جيش سوريا الجديدة أن يتولى مسؤولية محاربة تنظيم الدولة، بما أنه التزم بذلك من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تركيا والعراق والأردن في مطلع شباط الماضي. أما مستقبلاً، فلا بد من مراعاة دور سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وفي تلك الأثناء، سيتعين على دمشق معالجة مشكلة السجون والمخيمات التي احتجز فيها مقاتلو التنظيم مع عوائلهم. ويجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي تشجيع الولايات المتحدة على مواصلة دعمها لمحاربة تنظيم الدولة وتمويل مقار الاحتجاز، وفي الوقت ذاته، يجب على الدول الأوروبية أن تحرص على إجلاء مقاتلي تنظيم الدولة الذين يحملون جنسيات أوروبية حتى تجري محاكمتهم في أوطانهم.
وأخيراً، يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي دعم تشكيل حكومة جامعة قائمة على المشاركة بشكل فاعل وصياغة دستور دائم لسوريا يعكس تنوعها العرقي والديني، لأن ذلك لا يعتبر ضرورياً فحسب من أجل نجاح العملية مستقبلاً، بل أيضاً لمنع إيران من استغلال أي توتر طائفي أو عرقي لمد نفوذها في سوريا، ولهذا السبب وغيره، يجب أن تكون الأولوية المركزية لأوروبا منصبة على الإسهام بإقامة مصالحة اجتماعية وسياسية في سوريا.
* Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) هو المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهو مركز أبحاث مستقل مقره في برلين، ألمانيا. يُعتبر من أبرز مراكز الأبحاث والاستشارات السياسية في أوروبا، ويُقدّم تحليلات ودراسات للحكومة الألمانية والبرلمان (البوندستاغ) حول القضايا الدولية والأمنية.
المصدر: Stiftung Wissenschaft und Politik
تلفزيون سوريا
——————————–
بعد فشل حكم الأقلية في سوريا… حكم الأكثرية السنية سيتكرس مع تداعيات على لبنان والمنطقة/ رياض قهوجي
كثر في الأسابيع الأخيرة الحديث عن حلف الأقليات في بلاد الشام لمواجهة صعود نظام جديد في دمشق تسيطر عليه الأكثرية السنية،
تحديث 21 أذار 2025
كثر في الأسابيع الأخيرة الحديث عن حلف الأقليات في بلاد الشام لمواجهة صعود نظام جديد بدمشق تسيطر عليه الأكثرية السنية، بحجة أن الإدارة السورية الحاكمة تتكون من مجموعات مسلحة إسلامية، وبعضها كان مصنفاً إرهابياً. وأكثر من يتحدث عن هكذا حلف هما إسرائيل وإيران.
فإسرائيل تقوم باستهداف واضح لمواقع السلطات السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا وجنوب دمشق بحجة إنشاء منطقة آمنة. إلا أنها تحضّر الأرضية لدروز سوريا وتشجعهم على تشكيل كانتون خاص بهم ويكونون خط الدفاع الأول عنها في الجنوب. أما إيران، فهي تتحدث عن الخطر على العلويين وتشجعهم على الانتفاضة ضد الحكم، والتحالف مع مكونات أخرى مثل الأكراد. لكن حتى الآن، لم تنل نظرية تحالف الأقليات دعماً قوياً من القوى العربية والغربية. ربما تكون تحظى بدعم روسي خفي، إنما موسكو تريد الحفاظ على مصالحها في سوريا، وطالما السلطات الجديدة هناك تسيطر على الوضع، فهي ستطوّر العلاقة معها على حساب حلفاء الأمس.
مضى على حكومة الرئيس أحمد الشرع ثلاثة أشهر في بلد يعم فيه الدمار والفساد وبحاجة ماسة لجهود تنهي الانقسامات الداخلية التي أحدثتها السياسات المذهبية لنظام الأسد. وليس مستغرباً التصاريح والشعارات التي ترفع من العديد في مناطق السويداء والساحل وفي شمال-شرق البلاد، فالنظام السابق لم يعمل على بناء هوية سورية تشعر المواطنين بأنهم متساوون في الحقوق، بل عمد إلى تهجير أكثر من عشرة ملايين شخص وقتل عشرات الآلاف منهم. وبالتالي، فان إعادة اللحمة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي ستكون من أصعب مهام الإدارة الجديدة لإصلاح الانقسامات التي خلفها نظام الأسد. ولن تستطيع الحكومة الجديدة نيل ثقة المجتمع الدولي بشكل كاف لرفع العقوبات كاملة عنها وتلقيها أموالاً لإعادة الإعمار من دون فرض استقرار وسلم داخلي وإشراك مكونات الدولة بالحكم.
لكن ما يجري في سوريا اليوم هو أكبر من إسقاط نظام وتولي مجموعة أخرى مقاليد الحكم. فهو عودة إلى حكم الأكثرية السنية في نظام سيطغى عليه فكر الإسلام السياسي نظراً لخلفية قياداته وعلاقتهم الوطيدة بتركيا. وهذا غير مسبوق في التاريخ الحديث لسوريا، ويشكّل مصدر قلق لإسرائيل التي كانت تحبذ وتدعم حكم الأقلية العلوية التي منذ حرب 1973، لم تسمح بوجود مصدر تهديد حقيقي للدولة العبرية. وفي حين كان حافظ الأسد يستغل علاقته بإيران و”حزب الله” لتحسين وضعه على طاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل، تحوّل ابنه بشار إلى أداة بيد إيران بعد الثورة السورية وفقد السيطرة على تحركات ميليشياتها على أراضيه، ما غيّر من المعادلات السابقة وأسقط الفيتو الإسرائيلي الذي حمى نظامه لسنوات.
أشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بكلمته في مؤتمر بروكسل الأخير إلى أن حكم الأقليات لم يحمِ الشعب السوري، بل تسبب بمقتل وتشريد مئات الآلاف، وهو كان يقصد السنة خصوصاً. فهو كان يشكو من ظلم واستبداد حكم الأقلية الذي جعل الأكثرية مواطنين من الدرجة الثانية. طبعاً لحق الظلم أيضاً بالأكراد والدروز وبعض العلويين في حقبة الأسد. إنما، لم يلتزم الأسد بأي تحالف للأقليات، بل استغلهم وقتل وسجن بعض قادتهم والعديد من أبنائهم. كما انخرط بمحور الممانعة ضمن حسابات جيوسياسية وشخصية أتت بالمنفعة عليه وعلى قادته وأبقتهم بالحكم. وبالرغم من إعطاء نظام البعث نفسه صفة العلمانية، إلا أن القرارات الداخلية في ما يخص التعيينات كانت طائفية ومذهبية بامتياز.
إسرائيل تنظر إلى سوريا اليوم على أنها ستشكل امتداداً لدولة يلعب فيها الإسلام السياسي دوراً أساسياً، وسيربطها تحالف دفاعي – اقتصادي وثيق بتركيا. لا يعكس توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف غالبية الإسرائيليين، فنتنياهو ينفذ سياسة اليمين المتشدد الذي يسعى لاستمرار الحرب الإقليمية وقضم أراضٍ سورية. فقد أعربت حكومة الشرع عن نيتها لإنهاء الحروب مع الجيران، في حين تحدث بعض قادة المعارضة الإسرائيلية عن الفرصة السانحة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السلطات السورية الحالية، فيكون اتفاق تطبيع يوقع مع حكومة الأكثرية السنية السورية.
لم يتحدث قادة إيران و”حزب الله” عن حلف أقليات بالعراق لحمايتهم من الأكثرية الشيعية. فبالرغم من أن نظام الحكم بالعراق هو فيدرالي، إلا أنه أعطى الأكراد فقط إقليمهم الخاص. ورغم مشاركة المكونين السني والكردي بالحكم، إلا أن الأكثرية الشيعية تسيطر على مفاصل القرار، وبات هذا الأمر مقبولاً عربياً ودولياً. وهكذا يرجح أن يصبح الحال في سوريا في الفترة المقبلة حيث باتت هناك قناعة لدى قيادات الغرب بأن حكم الأقليات قد فشل، ويمكن تحقيق استقرار أفضل بحكم الأكثرية.
وسينعكس هذا على لبنان الذي عادة ما يتأثر كثيراً بالتغيرات في سوريا. فـ”حزب الله” سيشعر بالحصار يشتد عليه من الشمال والشرق بعدما أخرجته إسرائيل من معظم الجنوب، وهذا سينعكس قلقاً وخوفاً داخل القوى الشيعية التي ستحاول الدفاع عن مكتسباتها السياسية التي حققتها في العقدين الأخيرين. وستسعى السعودية ومصر لتعزيز علاقاتهما مع سنة لبنان لتخفيف التأثير التركي عليهم من تركيا عبر الحكم في سوريا. ولكن بالرغم من ذلك ستشهد الساحة السنية اللبنانية تنامي الإسلام السياسي المتأثر بتركيا خاصة في منطقتي عكار وطرابلس حيث ينتشر الفقر والحرمان في عدة أحياء وقرى.
النهار العربي
—————————-
المجلس الأطلسي: مستقبل التعددية في سوريا بعد الأسد وتحديات الإدماج السياسي
ربى خدام الجامع
2025.03.20
بعد إزاحة نظام بشار الأسد، يواجه المشهد السوري مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاجتماعية، وسط تساؤلات حول مستقبل التعددية الدينية والعرقية في البلاد. وبينما تعهدت الإدارة الجديدة باحترام حقوق جميع المكونات المجتمعية، لا تزال هناك مخاوف بشأن مدى قدرتها على تحقيق اندماج حقيقي وشامل لهذه الفئات في النظام السياسي الجديد.
وفقا لتقرير المجلس الأطلسي، فإن هيئة تحرير الشام عملت، قبل حتى سيطرتها على دمشق، على مد جسور التواصل مع بعض الطوائف والمجتمعات المحلية، لا سيما في إدلب، حيث سعت إلى تطوير علاقات مع قيادات دينية واجتماعية لضمان استمرار الحياة العامة بشكل سلس. وتؤكد مصادر التقرير أن هذه الجهود شملت تمثيلًا سياسيًا محدودًا لبعض الفئات، إضافة إلى إعادة ممتلكات بعض العائلات وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم.
ويشير التقرير إلى أن العلاقة بين هيئة تحرير الشام وبعض المكونات المجتمعية لا تزال محل نقاش دولي، خصوصا في ظل خلفيتها الأيديولوجية. ورغم التحديات القائمة، هناك مؤشرات على محاولات للتهدئة وإيجاد صيغة للتعايش، إذ أجرت الهيئة مفاوضات مع ممثلين عن بعض الأقليات الدينية في مناطق مثل سلمية، طرطوس، مصياف، ونبل، سعياً لضمان إدارة محلية أكثر استقرارا.
ويؤكد التقرير أن هذه الجهود لم تخلُ من تحديات، حيث شهد الساحل السوري عنفا بعد مقتل عناصر من الأمن العام على يد فلول النظام المخلوع. وعلى سبيل المثال، يذكر التقرير أن بعض الأحداث الأمنية الأخيرة في القدموس تسببت في تزايد المخاوف بشأن استقرار المرحلة الانتقالية، إلا أن قيادات محلية تسعى إلى نزع فتيل هذه الأزمات من خلال تعزيز الحوار بين المكونات المختلفة.
يرى المجلس الأطلسي أن قدرة الحكومة الجديدة على بناء نموذج حكم يستوعب التنوع السوري ستكون عاملاً حاسما في نجاح المرحلة المقبلة. ويوصي التقرير بضرورة تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والدولية لضمان تمثيل حقيقي لجميع الفئات، إضافة إلى تطوير قنوات دبلوماسية واجتماعية تُسهم في بناء الثقة بين مختلف مكونات
ترجمة التقرير كاملاً:
خلال العام الفائت، وبعد فترة قصيرة من طرد هيئة تحرير الشام لبشار الأسد من سوريا، تعهدت الهيئة باحترام حقوق الأقليات، ولكن منذ أن تولت زمام الأمور في معظم أرجاء سوريا، ثارت مخاوف بعض أطراف المجتمع الدولي تجاه قادة سوريا الجدد الذين يتمتعون بخلفية جهادية، وذلك بخصوص احتمال تقويضهم لحقوق الأقليات أو إقصاء تلك الطوائف واستبعادها عن عملية الانتقال السياسي، وقد ثارت ثائرة تلك المخاوف من جديد إثر العنف الهائل الذي وجه ضد العلويين في الساحل السوري خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومع ذلك، ما تزال هنالك بعض بوادر الأمل على الأقل تجاه إشراك بعض الطوائف في سوريا بعد سقوط الأسد.
ثمة أسباب مشروعة للقلق على مستقبل الطائفة العلوية بشكل خاص، إذ في شهر آذار، شن متمردون علويون تابعون للنظام البائد هجوماً مخططاً له ضد قوات الأمن، فأسفر ذلك عن تعبئة قوات الحكومة وفصائل مسلحة مستقلة وطالبي ثأر من السنة رداً على ذلك، حيث تورط هؤلاء في عمليات إعدام جماعية وقتل طال أكثر من ستمئة مدني علوي ومتمرد جرى إلقاء القبض عليه، وذلك على مدار أربعة أيام تقريباً، وما تزال حركة التمرد التي شنتها عناصر تابعة للنظام البائد مستمرة.
إن هذا العنف وعجز الدولة عن السيطرة على قواتها والقوات المستقلة عنها، أذكى من جديد المخاوف بشأن أمان الأقليات، ولكن لا يجوز أن ننظر إلى تلك الأحداث المدمرة كمؤشر على مصير أقليات أخرى، لأن أصل العنف يعود إلى الحقيقة القائلة بأنه خلال الحرب السورية الدموية، شكل الشباب العلويون صلب القوات المقاتلة لدى النظام البائد كما كانوا خزاناً لأجهزة الاستخبارات، لدرجة جعلت الطائفة كلها مرتبطة بالنظام البائد وذلك من خلال سياسات الأسد والسرديات السنية المتطرفة، وهذه الديناميات السياسية والاجتماعية لا تنطبق على غيرهم من الأقليات.
بالنسبة لبقية الأقليات، ثمة مؤشرات إيجابية تفيد بأنهم سيتم إشراكهم في سوريا بعد الأسد، إذ حتى قبل دخول هيئة تحرير الشام إلى دمشق، نجدها قد مدت يدها للأقليات في إدلب لتشارك في الدبلوماسية بطريقة ناجحة راعت حساسياتهم وذلك على مدار خمس سنوات، إذ ذكر زعماء مسيحيون موجودون في إدلب بأن الهيئة بقيت تمد يدها لهم على الدوام، وحدث ذلك في البداية من خلال كبار الشخصيات الدينية، ثم من خلال ملحقين سياسيين جرى تعيينهم لهذا الغرض، ثم عمدت الهيئة إلى تعيين هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر وبالتالي ضمنت مشاركة تلك الطوائف بدلاً من أن يتم ذلك عبر حكومة الإنقاذ التي شكلتها الهيئة وغيرها من فصائل المعارضة لتدير إدلب. وهؤلاء الملحقون السياسيون كانوا مدافعين عن الطوائف في المنطقة، وحملوا طلباتهم إلى حكومة الإنقاذ وإلى قوات الأمن التابعة لهيئة تحرير الشام.
ومن خلال ذلك، استعاد المسيحيون في ريف إدلب وبالتدريج منازلهم وأراضيهم وعادوا للعب دور على المستوى العام. كما أوقفت قوات الأمن الهجمات التي تستهدف تجمعات المسيحيين، غير أن عملية المشاركة كانت طويلة ومتعبة، إذ في البداية خشيت قيادات الهيئة من تعرضها لانتقادات لاذعة من قبل المتشددين والشعبويين في إدلب، ولكن بمرور السنين، كبر المجتمع المسيحي واندمج بشكل كبير ضمن مجتمع إدلب وزادت مشاركته في الحكومة المحلية، وبذلك تراجعت مخاوف الهيئة رويداً رويداً.
وبعد أن تطورت الهيئة بفضل تلك التجربة، أخذت تشارك المجتمع السوري وقيادات السوريين في الشتات وذلك قبل أيام من حملتها العسكرية الأخيرة التي شنتها في أواخر عام 2024، إذ أسهمت تلك الحملة الدبلوماسية بضمان توسع الهيئة في سوريا من دون أن تستولي بالقوة على مناطق شاسعة تسكنها أقليات، وأسفرت تلك المناقشات التي قامت خلال الأسبوع الأول من كانون الأول من العام الماضي عن قيام علاقة قوية بين هيئة تحرير الشام ومسيحيي سوريا والطائفة الإسماعيلية كما بدأت حقبة جديدة من العلاقات مع طوائف وجماعات كانت تعتبر في السابق مقربة من النظام البائد.
البداية من نبّل والزهراء
أثار سقوط النظام البائد في حلب خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي هلعاً كبيراً في مدينتي نبل والزهراء الشيعيتين القريبتين من تلك المحافظة، بما أنهما كانتا في السابق محورين لخطوط الدفاع لدى نظام الأسد، ولذلك زعمت صفحات محلية عبر منصة الفيس بوك بأن ألفي مدني شيعي نزحوا من بيوتهم ولجؤوا في البداية إلى حلب ومن ثم إلى مدينة السفيرة، حيث شكل حزب الله وإيران شبكة ميليشياتية قوية، وبحلول الأول من كانون الأول، أضحت السفيرة تحت سيطرة المعارضة بشكل جزئي، وتخلت قوات النظام البائد عن النازحين، ما أسفر عن انتشار الذعر عبر منصة الفيس بوك بخصوص مصير المدنيين. وفي الثاني من كانون الأول، بدأت المفاوضات بشكل رسمي بين هيئة تحرير الشام وزعامات مجتمع النازحين وذلك بشأن عودتهم إلى بيوتهم في نبل والزهراء، وذلك بحسب ما أورده شخص عمل على تسهيل قيام تلك المحادثات.
بدأت المفاوضات بعد أن تمكن أفراد من النازحين من التواصل مع أحد الناشطين السياسيين المقيمين في الخارج، والذي ذكر بأنه ساعد في تخصيص خط لدى المكتب السياسي للهيئة وشارك في الوساطة أيضاً، وسرعان ما تطورت هذه التجربة الأولية إلى تنظيم صغير متعدد الطوائف ضم ناشطين مثلوا مجموعة من المجتمعات التي كانت ما تزال تحت حكم الأسد، وخاصة في مدينتي مصياف وسلمية حيث الغالبية الإسماعيلية، وكان جميع الناشطين متلهفين للمساعدة في تسليم مناطقهم بشكل سلمي.
إلى شرقي حماة..
توسع هذا النهج الدبلوماسي مع تقدم الهيئة نحو شمالي حماة، حيث لعبت مدينة سلمية الواقعة شرقي حماة، دوراً حاسماً في الدفاع عن النظام وذلك لاحتضانها مقار عدد من الميليشيات المهمة التابعة له والتي تنشط في الريف. ولكن ظهرت فيها أيضاً حركة ثورية نابضة تعود أصولها إلى ثمانينيات القرن الماضي، تزعمتها الغالبية الإسماعيلية في تلك المدينة، وعن ذلك يقول أحد الناشطين الإسماعيليين: “الإسماعيليون معارضون للنظام على الدوام، ولكننا نعمل بطرق سياسية ومدنية، بعيداً عن السلاح”. كما تضم سلمية المجلس الإسماعيلي الوطني السوري الذي يدعم ويوجه الطائفة الإسماعيلية في عموم سوريا، وهذه العوامل هي التي فتحت الباب أمام التفاوض مع الهيئة.
وبالحديث إلى زعيمة المجلس الإسماعيلي الوطني، رانيا قاسم، وغيرها من المسؤولين عن الأمن والمجتمع المدني، حول المفاوضات وما أسفرت عنه من علاقات مع الهيئة، تخبرنا قاسم أنه في الثاني من كانون الأول، تواصل المكتب السياسي للهيئة معها لبدء المحادثات، فترأستها برفقة ممثل عن مؤسسة آغا خان وهي منظمة إنسانية إسماعيلية دولية، وشاركت في المفاوضات أيضاً لجنة تنسيق شكلها مركز عمليات الطوارئ التابع للمجلس، وخلال المفاوضات اكتشفت قاسم أنها هي وغيرها من الزعماء يشاركون في تلك المحادثات نيابة عن كل الطوائف الموجودة في منطقة سلمية، وليس فقط عن الإسماعيليين.
وبحسب ما ذكرته قاسم، فقد ركز النقاش على مصير مقاتلي النظام البائد في المنطقة وعلى الطريقة التي ستدخل بها الهيئة إلى مدينة سلمية، وبحسب ما ذكره أشخاص آخرون، فإن المجلس رفض أن يعطي الحماية لأي مجرم موجود في المدينة، ووافق على منح المسلحين مهلة ليقوموا خلالها بتسليم سلاحهم والحصول على بطاقة هوية مدنية مؤقتة، وذلك بدلاً من الخضوع لسياسة التسوية العامة التي تنتهجها الهيئة والتي طبقتها على كامل البلد بعد سقوط الأسد. بالمختصر، لم يقدم المجلس للمجرمين أي غطاء للعفو عنهم، وبالمقابل، جرى الاتفاق على أن يضع المقاتلون التابعون للنظام البائد أسلحتهم عند دخول قطعات الهيئة إلى الطريق الرئيسي وهي في طريقها جنوباً نحو حمص. كما وافقت لجنة التنسيق على إرسال وفد إلى ضواحي سلمية وذلك للقاء مبعوثي الهيئة ومرافقتهم عند دخولهم إلى المدينة.
تعتبر تلك المفاوضات خطوة أولى مهمة في علاقة هيئة تحرير الشام مع الطائفة الإسماعيلية الموجودة في سلمية، إذ بحسب ما ذكرته قاسم، فإن المجلس أمضى الأيام الثلاثة من المفاوضات وهو يكرر على مسامع أهالي سلمية بأن: “المجلس والطائفة لن يقاتلا، وإذا أردتم أن تقاتلوا فالقرار قراركم”، وهذه الرسالة وصلت إلى بعض من أنصع القرى العلوية سمعة، مثل قرية الصبورة، حيث تعاون مع المجلس معتقلان سياسيان علويان سابقان مؤيدان للثورة من داخل قريتهما وذلك على ضمان موافقة المقاتلين في منطقته على وضع أسلحتهم. غير أن المجلس الإسماعيلي نفسه لم يرتبط بأي فصيل مسلح ولم يتواصل مع أي من القيادات العسكرية لدى النظام البائد، إذ أكدت قاسم بأنهم لم يتفاوضوا مع أي فصيل مسلح تابع للنظام البائد أو باسمه.
ولذلك وثقت قيادات الهيئة بالمجلس الإسماعيلي الذي تأكدت من أن له التأثير المطلوب من أجل تهدئة ميليشيات النظام البائد ولضمان دخول الهيئة بشكل آمن إلى المدينة والقرى المحيطة بها، ولهذا لم تحدث سوى مناوشة صغيرة واحدة في قرية تل خزنة على الطريق الجنوبي باتجاه حماة، وما عدا ذلك، لم يحدث إلا تسليم سلمي لشرقي حماة في الرابع من كانون الأول، وذلك بحسب ما ذكره مسؤولون أمنيون محليون وأعضاء في المجلس الإسماعيلي. وبحسب ما ذكرته قيادات إسماعيلية في سلمية وطرطوس، أتى رد نظام الأسد على تلك المفاوضات السريعة عبر إرسال مسؤولين أمنيين إلى المجلس الإسماعيلي في طرطوس وتهديدهم وإخبارهم بأن أقاربهم في سلمية ما هم إلا “خونة”، ولكن النظام انهار قبل أن ينفذ هؤلاء المسؤولون تهديداتهم.
وخلال فترة المفاوضات التي امتدت لثلاثة أيام، قامت مفاوضات أخرى على مستوى فردي، إذ بدأ مقاتلو المعارضة التابعون لكل من الهيئة وغيرها من الفصائل التي تعود أصولها إلى سلمية بالتواصل مع أصدقائهم وأهاليهم الموجودين في قراهم، إذ يتذكر أحد القادة كيف اتصل بأهله عند اقتراب قطعته من شرقي حماة وطلب منهم ربطه بمختار القرية ويعلق على ذلك بقوله: “لم أكن لأخاطر بحمل السلاح ضد أبي أو أخي”، والآن أصبح هذا الشاب رئيساً لمفرزة الأمن العام في الريف المحيط بقريته التي تضم خليطاً من الطوائف، ويعتبر نفسه مسؤولاً عن حماية أهلها بصرف النظر عن طوائفهم.
كان تسليم منطقة سلمية بداية للمحادثات بين الهيئة والمجلس الإسماعيلي، وذلك بحسب ما ذكرته قيادات إسماعيلية، لأن المجلس الوطني يشرف على عدد من الفروع المحلية ومن بينها الفرعان الموجودان في طرطوس ومصياف، وبما أن النظام كان ما يزال يسيطر على غربي سوريا، لذا بدأ المجلس الإسماعيلي بالتفاوض نيابة عن الطوائف الموجودة في تلك المنطقة، ومن جانبها، أنهت الهيئة عملياتها على جبهة مصياف في اليوم الذي تحررت مدينة حماة، وأوقفت تقدمها باتجاه الغرب على تخوم سفوح الجبال التي يسكنها إسماعيليون وعلويون. وذكرت قيادات إسماعيلية بأنهم شرعوا بمشاركة خبراتهم الإيجابية والتعاون مع الهيئة وجهات الاتصال التابعة لها في مدينتي محردة والسقيلبية اللتين كانتا تؤيدان النظام بشكل كبير، واللتين كفتا عن القتال لكنهما بقيتا محاصرتين من قبل الهيئة، وسرعان ما أنهت هاتان المدينتان مفاوضاتهما التي أسفرت عن دخول سلمي لقطعات الهيئة إليهما.
أساس لسوريا الجديدة
يبدو أن المفاوضات الأولية وضعت أساساً متيناً للثقة التي كبرت وتجاوزت سلمية، إذ بحسب ما ذكره أحد قادة المجلس الإسماعيلي في طرطوس، فإن المسؤول العسكري المحلي للهيئة التقى بالمجلس بعد يوم من دخولها إلى طرطوس، إذ يومئذ دعي المجلس لاجتماع عام ضم ممثلين محليين ومسؤولي الهيئة، وخلال ذلك الاجتماع جرى فتح خط جديد للتواصل مع الممثل السياسي للهيئة، وفي الختام دعي الجميع لحضور اجتماعات مع المحافظ الجديد لطرطوس. أي أن كل تلك التطورات حدثت في غضون عشرة أيام فحسب، ويصف أحد المسؤولين الإسماعيليين في طرطوس ما جرى فيقول: “يبدو أن الحكومة الجديدة تحترم الطائفة الإسماعيلية بحق وتجمعها علاقة خاصة بها، إلا أن ذلك كان مفاجأة كبيرة لأننا لم نتحدث معهم ألبتة قبل الآن، وكانت لدينا المخاوف نفسها التي كانت لدى العلويين وبقيت لدينا حتى كانون الأول”.
توضح الحملة الدبلوماسية للهيئة النهج السياسي لقيادتها، والذي تطور على مر السنين عبر التعامل مع الطائفتين المسيحية والدرزية في إدلب، وقد برر قادة الهيئة تلك السياسات الجديدة قبل سنوات على أنها ضرورة سياسية لحكم بلد متنوع مثل سوريا في يوم من الأيام ولشرعنة الحركة بين الأقليات التي لا تعرف عنها شيئاً سوى أنها كانت تابعة لتنظيم القاعدة، ثم صار اسمها جبهة النصرة، فقد بدأت تلك الفكرة التي تقول إنه لا يمكن لسوريا أن تُحكم كدولة إسلامية سنية (بل كدولة متنوعة الأعراق والأديان) خلال الفترة التي أعقبت سقوط الأسد، وذلك على مستوى الإدارة المحلية والأمن على أقل تقدير.
ولذلك، وضعت المفاوضات الأولية مع سلمية أساساً متيناً للتعاون الذي استمر بالنمو والتطور، وكفل للإسماعيليين في مختلف أرجاء سوريا إحساسهم “بالثقة بأنهم سيمثلون بشكل كامل في العملية الدستورية” وذلك بحسب ما ذكره رئيس مكتب طرطوس. هذا، ويلعب المجلس الإسماعيلي في سلمية اليوم دوراً مركزياً في إدارة المنطقة، إذ يعمل على تسهيل المشاركة المدنية والسياسية، وإدارة المتطوعين في قوى الأمن وذلك لمساعدة الشرطة المحلية، إلى جانب استقباله للجنة أمنية مكونة من ممثلين أحدهما مدني والآخر عسكري، وذلك لمعالجة الثغرات الأمنية وأي انتهاكات ترتكبها قوات الحكومة.
أصبحت تلك العلاقات أمتن بكثير في مدينة القدموس الساحلية، إذ بحسب ناشطين إسماعيليين مقيمين فيها، فإن قوة صغيرة تضم متطوعين إسماعيليين صارت تدعم قوات الشرطة التابعة للحكومة نظراً لنقص عدد رجال الشرطة في القدموس منذ كانون الأول الماضي. وقد قدمت قوات الحكومة لهؤلاء المتطوعين أسلحة صغيرة، في حين أن المجلس المحلي الجديد الذي يديره إسماعيليون يتعاون عن قرب مع المختار الذي عُيّن أيام الأسد، وهو أيضاً ينتمي للطائفة الإسماعيلية، بحيث يقومون جميعاً بتنسيق أمور الخدمات والإدارة مع المدير المحلي الذي عينته الهيئة. وقد شارك المجلس أيضاً بالتواصل مع القرى العلوية المحيطة بالقدموس، فعمل كجسر بين الإدارة المحلية الجديدة والعلويين.
وعلى الرغم من تلك الجهود، فإن العلاقة الوطيدة مع الحكومة الجديدة جعلت الإسماعيليين في القدموس هدفاً رئيسياً للعلويين الموالين للأسد الذين قتلوا متطوعين إسماعيليين اثنين لدى قوات الأمن في أواخر شهر شباط، وعضواً في المجلس الإسماعيلي وضابطين لدى جهاز الشرطة التابع للحكومة في السادس من الشهر الجاري. وعند بدء الانتفاضة في آذار، حاول الإسماعيليون حماية قوات الحكومة في المدينة، وتفاوضوا في نهاية الأمر على خروجهم من المنطقة بأمان بعد أن حاصرها المتمردون. ولكن، ونتيجة لذلك، تعرضوا لتهديدات كثيرة من فلول الأسد وصلت إليهم إما مشافهة أو عبر تطبيق واتساب، وذلك “لانحيازهم للحكومة” بحسب ما ذكره أهالي المنطقة. وفي نهاية المطاف، عادت قوى الأمن لدخول القدموس بشكل سلمي بحسب ما ذكره أهاليها، لأن تلك التجربة وطدت علاقتهم بدمشق. ولذلك تطوع كثير من الشبان الإسماعيليين لمؤازرة قوات الأمن التابعة للحكومة، بل إن بعضهم تقدم ليصبح ضابطاً رسمياً ضمن قوات الأمن. وفي تلك الأثناء، ناقش مسؤولون أمنيون محليون فكرة زيادة الرواتب المخصصة لجميع المتطوعين في تلك القوات، وعلى الرغم من الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الفائت، بقي المجلس المحلي للمدينة يعمل كوسيط بين قوات الأمن المحلية والقرى العلوية، إلى جانب عمله في التفاوض على تسليم الأسلحة والمطلوبين من المجرمين.
وفي تلك الأثناء، وصف قادة المجتمع المدني المسيحي في المنطقة الساحلية المتوترة علاقة التعاون مع المديرين الذين عينتهم الهيئة في المنطقة ومع مسؤوليها المعنيين بالأمن بأنها وطيدة ومتينة، وعلى الرغم من أن القلق ما يزال يساور عدداً من الناشطين والقيادات المسيحية في المنطقة بخصوص تأمين الخدمات الأساسية ووضع الاقتصاد والعملية الدستورية، فإنهم ذكروا خلال شهر شباط بأنهم لم يخشوا من الهجمات المباشرة من طرف الحكومة الجديدة بل قلقوا من أن يتحولوا إلى رهينة للعنف المتنامي ما بين فلول الأسد وقوات الحكومة، إذ كان قادة المسيحيين في مختلف أرجاء سوريا من أوائل الرجال الذين تعاونوا مع قوات الأمن الموالية للحكومة خلال الأيام التي أعقبت سقوط الأسد، حيث نشروا عبر صفحاتهم على الفيس بوك صوراً للاجتماعات التي عقدت بين قادة عسكريين وسياسيين وشخصيات دينية في ريف دمشق وحمص وحلب. ومع تصاعد العنف في الساحل خلال شهر آذار، شدد رئيس الطائفة الكاثوليكية في حلب، المطران حنا جلوف، على أهمية توحيد سوريا، وأكد على المعاملة الطيبة التي يتلقاها المسيحيون في مختلف أرجاء البلد، ودعا لمواصلة الجهود الساعية لإدماج كل الطوائف في العملية السياسية بشكل كامل.
لا بد لشبكات وعلاقات الحوار بين الأديان والعمل المدني التي تشكلت مؤخراً أن تلعب دوراً محورياً في رسم شكل سوريا بعد الأسد، ولكن ينبغي على الحكومة الجديدة أن تقدم المزيد لإشراك وتمكين الطوائف مثل الطائفة الإسماعيلية والمسيحية، كما يجب عليها فعل ذلك على المستويين المحلي والدولي وذلك عبر التعاون مع مؤسسات مثل مؤسسة آغا خان (وذلك لتقدم تطمينات للإسماعيليين)، بل حتى مع الفاتيكان (وذلك لتطمئن المسيحيين)، لأن هذه الجهود لا بد أن تسهم في بناء ثقة الشارع بها وزيادة تلك الثقة بين أفراد تلك الطوائف عبر تمثيلها بشكل حقيقي في دمشق، وحتى يتحول ذلك إلى مبرر حقيقي للتفاؤل بشأن مستقبل الأقليات في سوريا.
المصدر: The Atlantic Council
تلفزيون سوريا
———————————-
السوريون يقتلون الاسد رمزياً
دمشق – المدن
الجمعة 2025/03/21
“إصبع غضّ يخرج من ثقب الجراب المهترئ” ــ بهذه الصورة الرمزية العالية، يفتتح الروائي محمد علوش روايته حكاية سورية، معرّفاً بالماضي الفقير لبطلها، وصولاً إلى حاضر مغاير يشكّل ذلك الثقب جزءاً منه. في سردٍ يعكس تجربة شخصية تمتد إلى واقع أوسع، يذكّرنا الكاتب بلحظات مألوفة مرّ بها الكثيرون: الخشية من خلع الحذاء خشية انكشاف جراب مثقوب، وربما مرقّع من أماكن عدة ــ تمامًا كواقعٍ لطالما بُني على خياطة الأفواه قبل رقع الملابس.
في اليوم التالي لهروب النظام البائد، بدت السردية حاضرة بقوة: بلدٌ منهك، شعبٌ يبحث عن معنى جديد للحياة، وصورٌ عائلية مهجورة تُركت في بيت الرئيس المخلوع، تداولها السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل حيّ على زوال الطغيان.
لكن المفارقة لم تتوقف عند الصور، بل تحولت إلى تجارة جديدة: جوارب وملابس داخلية طُبع عليها وجه الديكتاتور ووالده، باتت تُباع في شوارع دمشق وعلى واجهات المحلات والبسطات. يقول أحد الباعة لـ”المدن” إنه يبيع ما يقارب خمسين قطعة يومياً بأسعار مرتفعة، ما دفعه وزملاءه إلى توسيع تجارتهم في ظل الطلب المتزايد.
وفي مشهد آخر من هذا الانقلاب الساخر على إرث الطغيان، دوّن بعض باعة الخضروات عبارات مثل “بصل أرخص من بشار” دون أن تُفتح أبواب السجون في وجوههم، بينما كانت بارات دمشق تصدح ليلاً بأغانٍ جديدة على وقع الهتاف: “مندوسهم مندوسهم… بيت الأسد مندوسهم”.
تحمل الصورة رمزية عميقة تستند إلى أفعال غرائزية تهدف إلى تحقير الطرف الآخر، عبر توظيف موضعين يُنظر إليهما في الثقافة الشرق أوسطية كمراكز للنجاسة والامتهان: القدمان، التي يُمارس بها الدعس، والأعضاء الجنسية، التي تُستخدم كرمز للاحتقار. لكن الأهم من ذلك، أن هذا الفعل يتجاوز دلالته المباشرة ليصبح شكلاً من أشكال التنفيس النفسي عن سنوات القهر والذل، ووسيلة للقتل الرمزي، تمامًا كما يُحرق رجل القش في طقس انتقامي يعبّر عن رفض نظامٍ أمعن في إحراق البلاد تحت ستار الطائفية التي كرّسها بممارساته… لنعيش ارتدادتها حتى اليوم.
صدام طائفي
يعد شارع الأمين الدمشقي، الممتد من جادة الخراب إلى ابن عساكر، واحد من أبرز معالم العاصمة السورية، والذي أطلق عليه في بداية الخمسينات اسم العلامة السيد محسن الأمين العاملي، أحد أشهر مجتهدي الشيعة الإمامية في بلاد الشام. يُعتبر هذا الشارع بمثابة معقل للشيعة في دمشق.
ومع ذلك، يشهد الشارع بين الحين والآخر أحداثاً تزعزع الاستقرار وتعكر صفو الحياة اليومية، كان آخرها صدام وقع بين عناصر من الأمن العام وشباب الحي. فبعد طلبهم من المطرب في أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة أن يؤدي “اللطميات”، بدأ الشبان بضرب صدورهم في حركة استفزازية. لم تقتصر الأحداث عند هذا الحد، بل قام شاب “شيعي” من سكان الحي بتسجيل فيديو توعد فيه أهل الشام، بالإضافة إلى شتم رموز دينية تعتبر مقدسة بالنسبة لهم، ما استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً في المنطقة لضمان عدم تصاعد الأوضاع إلى اشتباكات طائفية… واقتيد بعض الشباب اإلى “قسم العمارة” اقتياداً لم يخل من ممارسات خاطئة تم تداركها والإفراج عن الشباب بعد عدة أيام في مشهد يذكر ببعض ممارسات حكم الأسد الذي عاشت أحياء دمشق القديمة، بما في ذلك شارع الأمين، واقعاً مضطرباً ومريراً في عهده، حيث كانت الحرائق تلتهم البيوت والمحلات التجارية في حال امتناع أصحابها عن بيع ممتلكاتهم لجهات إيرانية. غالباً ما كانت هذه الحوادث تُحيل إلى “ماس كهربائي”، كما حدث في الحريق الذي دمر أحد المحال التجارية وبعض المنازل المجاورة بالقرب من مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حارة “القساطلية” بحي الأمين الدمشقي.
هذه الحرائق لم تكن مجرد حوادث عابرة، بل كانت تحمل في طياتها دافعاً عميقاً لتغيير هوية المنطقة. في تلك الأيام، اكتست دمشق بالسواد بين ليلة وضحاها، مع محاولات حثيثة لتغيير الطابع الثقافي والديني للمناطق، حيث بدأ المتشيعون الجدد يرتدون ثياباً مكتوباً عليها شعارات مثل “لبيك يا حسين” و”لبيك يا زينب”، دون أن يجدوا من يوقفهم أو يمانعهم.
أما الأحياء المجاورة لمقام السيدة رقية فقد تحولت بشكل تدريجي إلى مناطق إيرانية خالصة، مما عمق الانقسام الديني والطائفي في المدينة، وأدى إلى تغيير جذري في ملامحها الثقافية والاجتماعية.
تتغير الأدوار اليوم في شوارع دمشق القديمة، حيث تجوب سيارات “الهداية إلى الإسلام” بين الأزقة العتيقة، في مشهد يثير الدهشة، إذ تلتقي هذه السيارات مع البارات التي تنتشر على أطرافها وتغرق في حياة المدينة المليئة بالأنشطة المدنية. أصبحت هذه الأماكن متنفساً لشباب دمشق، وللغرباء الذين يقصدونها، لكن الصوت الذي يعلو على صوت الموسيقى وأجواء السهرات هو صوت الدعوة للإسلام. “ومن يرضى بغير الإسلام دينًا فهو تائه”، تُسمع هذه الكلمات تصدح في الأرجاء، إلى جانب الأناشيد التي تقول: “مسلماً كنت وسأبقى مسلماً، تشهد الأرض بذلك والسما”.
توترات متزايدة
هذه الأنشودة التي تعلو في حي باب توما الدمشقي، الحي الذي يشتهر بكثرة سكانه المسيحيين، أثارت خلافاً بين شباب الحي وسائقي إحدى سيارات الهداية، حيث تدخل أحد السكان المسلمين، الذي أكد أنه مسلم ولا يحتاج إلى “الهداية”. هذا المشهد يعكس التوترات المتزايدة في المدينة، حيث تلتقي الاختلافات الدينية والثقافية، وتثير أسئلة حول حدود الدين في الفضاءات العامة ومدى قبول الآخر…. ما دفع شاباً سورياً للرد على النشاطات الدعوية بطريقته الخاصة حيث رفع علم سورية الجديد وتجول في المالكي إلى جوار بيت الرئيس الشرع واضعاً تراتيل مسيحيه “المجد لك ايها المسيح ابن الاله” داعياً إلى الحرية منادياً بالحرية التي بات يعيشها اليوم قائلاً: “ما يحق لمكون من الشعب السوري من امتياز، يحق لباقي المكونات، وعندما تغيب القوانين والأنظمة عن هذه الدعوات التنظيمية والتبشيرية يحق للجميع فعل ذلك”.
تعيش مدينة دمشق اليوم حالةً من التخبط، ولكن رغم الخراب الذي يحيط بها، تظل محبتها نابضةً في قلوب أبنائها. ما يحدث الآن ليس سوى تداعيات ما بعد الحرية، بعد سنوات طويلة من القهر والظلام. واليوم، أصبحت دمشق حرةً حقاً، وشعبها يطير فرحاً بأربع ساعات من الكهرباء التي تغذي معظم المدن السورية بعد سنوات من الانقطاع المتواصل. هذه اللحظات الصغيرة أصبحت بمثابة علامة على النهوض من الركام، وحلم جديد يشرق في الأفق بعد سنوات من التحديات.
—————————–
حرب لبنانية سورية؟/ يوسف بزي
الخميس 2025/03/20
قبل أي نزاع حدودي بين لبنان وسوريا، وقبل حزب الله وحكم الأسدين والثورة السورية وجبهة النصرة وانتخاب جوزاف عون وتنصيب أحمد الشرع رئيساً.. بل قبل الحروب اللبنانية كلها، كانت تلك الجرود والسهول “النائية” موطن زراعة حشيشة الكيف، والتهريب، ونزعة التمرد العشائري، والسكان الذين لم يتأقلموا يوماً مع مبدأ الحدود والانضباط وفق موجباتها، والانصياع لقوانين الدولة.
واقترن هذا بتفاوت تنموي مع المناطق الأخرى، للأسباب المذكورة آنفاً، مضافاً إليها ماضٍ من الإهمال الرسمي، لم يُتح استدراكه مع توالي الحروب والنكسات التي هشّمت الدولة وأضعفت قدراتها، وغيَّبت الاستقرار. وعلى هذه الحال، ما كان ممكناً إلا بقاء تلك المناطق مضطربة، تحكمها فوضى السلاح والأعمال غير المشروعة.
ومنذ الثمانينات، كانت السيادة على تلك المناطق تتقاسمها وصاية سورية مخابراتية وأمنية لصيقة ومتغلغلة في الحياة اليومية، ونفوذ سياسي تام موزّع بين حركة أمل وحزب الله، وولاء عشائري وعائلي يسمو على أي قانون أو ولاء آخر. أما الدولة، فكان متاحاً لها فقط الدور الخدماتي بحده الأدنى.
وهذا العقد غير المكتوب، رعى على امتداد 40 عاماً مجتمعاً مسلحاً، تزدهر فيه أعمال العنف وتأليف عصابات الخطف، وسرقة السيارات، وزراعة الممنوعات، وتهريب البضائع، وتزوير العملات، والقتل باسم الثأر أو الشرف، وإن بدا هذا افتراء على شطر واسع من السكان “يحلم” بالخروج من هذه الوصمة.
مع اندلاع الثورة السورية وتدخل حزب الله العسكري إلى جانب النظام، انطلاقاً من تلك المنطقة، وخوضه خصوصاً معركة القصير والقلمون، بالموازاة مع صعود تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش”، اللذين مارساً أعمالاً إرهابية وهددا الداخل اللبناني نفسه، عدا عن توغلهما داخل الحدود اللبنانية ومهاجمة القرى واحتلال الجرود والتلال.. بدا أن الحدود التي استباحها حزب الله ما عادت أيضاً محرمة على التنظيمات المسلحة السورية. وإذ انتهت معارك الجرود، ومن ثم “انتصر” الحزب والنظام السوري واستتب الأمر لهما لنحو عشر سنوات، نشأت شبكة اجتماعية وعسكرية واقتصادية، قوامها احتلال الحزب لبلدات وقرى ومزارع سورية، وإدارته لطرق ومعابر ومنشآت وقواعد ومخازن، ومشاركته للفرقة الرابعة (ماهر الأسد)، المنافع والمغانم المتأتية من أعمال زراعة المخدرات وتصنيعها وفرض الأتاوات والتهريب بالاتجاهين والإتجار بالنفط والسلاح، والتواطؤ مع العصابات التي راحت تزدهر تحت غطاء عشائري حيناً أو باسم “المقاومة” ودعم النظام “الممانع” الأسدي، وحماية خطوط المدد الإيراني، معظم الأحيان.
ولا ننسى أيضاً، أن النظام السوري الساقط رفض مراراً وراوغ في ترسيم الحدود، وكانت المحاولة اللبنانية اليتيمة عام 2005، وفشلت حين قُتل المسّاح في الجيش اللبناني، عمداً على يد ميليشيا تابعة للمخابرات السورية.
كذلك، يتناسى اللبنانيون المسؤولية الثقيلة في شراكتهم بالمقتلة السورية. فحزب الله كان جزءاً لا يتجزأ من السلطة اللبنانية، ومتطوعوه بالآلاف كانوا عاملاً مؤثراً في الحرب السورية وما نتج عنها من مآسٍ، منها التهجير المليوني من أرياف دمشق وحمص وصولاً إلى حلب والبوكمال. وهذا لم يورث سوى الضغينة العميقة في نفوس أكثرية السوريين، خصوصاً منهم سكان المناطق المحاذية للحدود اللبنانية، الذين استولى حزب الله وموالوه على أراضيهم وبيوتهم وبساتينهم.. واتخذت تلك الضغينة طابعاً مذهبياً مشهوداً.
وبطبيعة الحال، كان سقوط الأسد “هزيمة” إضافية وقاصمة لحزب الله، وكارثة اقتصادية لأهل التهريب والمخدرات وأعمال الخطف وتجارة السلاح وما شابه، وخسارة فادحة للممتلكات المستباحة وللمصانع المشبوهة. سقوط جلب معه خطر انتقام المنتصرين، أو على الأقل خطر إغلاق الحدود والتهجير من أماكن وقرى يقطنها لبنانيون في الداخل السوري، بسبب هويتهم وحسب.
وهكذا، ما بين نزعة عشائرية قديمة للتفلت من سيادة الدولة، ومشروع دويلة حزب الله، وما يكتنفها من سياسة القوة والعنف والاقتصاد الأسود، ونظام سوري مافياوي وإجرامي، وتداعيات حرب كارثية اصطبغت بطابع مذهبي.. تشكلت جغرافيا متفجرة، تصل إليها أرتال الجيش اللبناني اليوم برفقة صيحات شائنة، توصم الجنود اللبنانيين بالخونة والعملاء، فيما على الجانب الآخر من الحدود، تعتمل مخاطر حرب طائفية، تسعى إليها بقايا الفرقة الرابعة ورديفاتها، وتشجعها علناً دولة إقليمية “خسرت” سوريا وخطوط إمدادها، وتصاحبها إسرائيل بالابتهاج والغارات والمراقبة الصارمة.
وهذا كله من ثمرات احتقار الدولة الوطنية وازدراء الحدود.. والاعتصام بالسلاح والتهدج بالمظلومية والحرمان، وإلقاء المسؤولية على العدو.
في المحصلة، في تلك المنطقة، كما في جنوبيّ لبنان وسوريا، يرتسم مصير الدولة السورية الوليدة، ومشروع استعادة الدولة والسيادة في لبنان.
المدن
—————————–
النظام السوري الجديد: النكوص إلى «الاقتصاد الحرّ»/ ورد كاسوحة
تحديث 21 أذار 2025
مجيء السلطة السورية الجديدة بتصوُّر مسبق عن الاقتصاد، فحواه الانتهاء من النموذج الاشتراكي في الحكم لمصلحة ما تسمّيه «الاقتصاد الحرّ»، وضع منذ البداية حدوداً لما يمكن توقُّعه منها، على مستوى «الإصلاحات المُزمَعة».
البداية كانت من تعليق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، حيث بدا الإجراء الذي ابتغى توفير أكبر كمية ممكنة من السلع للسوريين بمنزلة، ليس فقط محاولة لكسب شرعية اقتصادية من الناس، بل أيضاً مفاضلة بين نهجين في دعم الصناعة، لمصلحة الأجنبية منها.
الانهيار الكبير في أسعار هذه السلع، بسبب وصولها إلى السوق السورية بسعر التكلفة، كان على حساب نظيرتها المُنتَجة في الداخل، حيث بدت السلع السورية غير قادرة، بسبب استمرار ارتفاع تكلفة إنتاجها، على منافسة البضائع المورَّدة من الخارج بتسهيلات كبيرة، لا سيّما التركية منها.
في الاقتصاد السياسي للسلع، لا تعبّر القدرة الشرائية المدفوعة بتعليق الرسوم الجمركية، بالضرورة، عن منحى إيجابي، لأن الطلب هنا لا يكون تحت تأثير الزيادة في الأجور بقدر ما هو نتاج تسهيلات في عملية التبادل الجاري، على حساب السلع المُنتَجة داخلياً. العنصر الإيجابي الذي تمثّله إمكانية الحصول، بيُسر وسهولة، على البضائع الأجنبية، يحتاج إلى بنية داخلية معادِلة لإجراء تعليق الرسوم الجمركية. أي لجهة القدرة، ليس فقط على الحصول على السلع المحلّية بالقَدْر نفسه من السهولة، بل أساساً توفير بنية إنتاجية لها، تتيح لها إمكانية البقاء في السوق، والصمود في مواجهة المنافسة غير المتكافئة حالياً مع السلع الأجنبية.
التباسات تحرير الاقتصاد
ثمّة، مع ذلك، إيجابية ملموسة في تخفيض الرسوم الجمركية لا بدّ من ذكرها، حتى لو كانت تتعارض مع النواحي السلبية الآنفة الذكر.
وهي تتمثّل في الحصول على المواد الأوّلية اللازمة للصناعة، من الخارج، بتكلفة زهيدة، ما يجعل تكلفة الإنتاج، بالنسبة إلى الصناعيين والمنتجين المحلّيين، منخفضة بدورها، وهذا ينعكس فوراً على أسعار هذه المنتجات، لجهة توافرها في السوق بأسعار منخفضة.
والحال أنّ ذلك يتناسب، بمقدار معيّن، مع انخفاض القدرة الشرائية حالياً، بفعل حالات الصرف والفصل من الوظائف، فضلاً عن التأخير المستمرّ في دفع الرواتب والأجور تحت تأثير أزمة السيولة بالليرة.
ثمّة تناقضٌ هنا بالطبع، بين انخفاض نسبة التضخّم وضعف الطلب على السلع والخدمات، غير أنّ ذلك يعدّ «أمراً طبيعياً» في سياق ما تشهده البلاد من تغيير بنيوي في ماهية الاقتصاد وبنيته، حيث الانخفاض في الأسعار وفي سعر الصرف لا يعبّر عن تحفيز لعملية الإنتاج، بقدر ما يؤشّر إلى تغييرات في بنية العرض والطلب، سلعياً ونقدياً، وصولاً حتى إلى المعروض والمطلوب من اليد العاملة، بعد التغيير الكبير الذي طال كتلتها في مؤسسات القطاع العامّ.
أمّا بالنسبة إلى السيولة بالليرة، فالاختلاف عن بنيتها السوقية في العهد السابق لا يقلّ جذرية عن نظيرتها الخاصّة بالعمالة، لجهة الانتقال من منهجية التيسير إلى التشديد.
وهو ما يفسّر ليس فقط بقاء سعر الصرف الرسمي عند عتبة أعلى من نظيره السوقي، خلافاً لما هو متعارف عليه نقدياً، حتى في الاقتصادات الطرفية التي تعتمد اقتصاد السوق، بل أيضاً التذبذب أو التأرجح المستمرّ في سعر الصرف بين عتبتي الـ 10,000 و12,000، بدلاً من الثبات لسنوات عند عتبة الـ14,700، كما كان عليه الحال في حقبة النظام السابق.
لا بدّ من الإشارة في هذا السياق، إلى الدور الذي يلعبه الفارق الكبير بين سعري الصرف، الرسمي والسوقي، فهذا الأمر لا يبقي أسعار السلع والخدمات عند عتبة منخفضة فحسب، بل يساعد أيضاً على تدفُّق السيولة، بعيداً من التجار والسوق السوداء للعملة الأجنبية. المحافَظة على الفارق بهذا الشكل، تسمح للبنك المركزي بالتحكّم في السيولة الموجودة في السوق، إذ يبقى الطلب على السلع والخدمات منخفضاً نتيجة عدم توافر سيولة كافية بالليرة، وفي الوقت ذاته يعوَّض عن افتقاد الخزينة للعملة الأجنبية، التي تذهب في مجملها، سواءً تلك المدّخَرة منها أو الآتية عبر التحويلات الخارجية، إلى شركات الصرافة المرخّصة والبنوك التي تعتمد سعر الصرف الرسمي.
خيار التقشّف ووضع سقوف لسحب السيولة
بالمجمل، يمكن اعتبار كلّ ما سبق، لا سيّما لجهة الاقتصاد في طباعة النقد وتوفير السيولة بالعملة المحلّية، بمنزلة انعطافة واضحة نحو سياسات التقشّف، التي لم تعرفها سوريا في تاريخها المعاصر، حتى قبل وصول البعث إلى السلطة في عام 1963. «الاضطرار النقدي» إلى حبس السيولة بالعملة المحلّية بهذه الطريقة، نظراً إلى افتقار الخزينة للنقد بشقّيه المحلّي والأجنبي، لا يبرِّر السياسات الاقتصادية التقشّفية الأخرى، على مستوى قطاعات الإنتاج والخدمات المقدّمة من الدولة، إلى درجة يبدو معها أنّ التقاطع بين التهجين هو السمة السائدة في المرحلة المقبلة. فالرغبة المعلنة لدى المركزي في التقليل من طباعة أوراق نقدية جديدة، والتي يبرِّرها بالحاجة إلى إبقاء سعر صرف الليرة مرتفعاً وعدم التسبُّب في زيادة التضخُّم، تقابِلها، على نحو متقاطع، إجراءات التخفيف من كتلة اليد العاملة في المؤسّسات والمعامل المملوكة للدولة. هذا يضع الرغبة في تحفيز سعر صرف الليرة والحدّ من التضخّم خارج سياق استفادة الأكثرية منها، لجهة تعزيز الوظائف بدل الحدّ منها، ووضع السيولة في يد المستهلكين عوضاً عن سحبها منهم بطريقة غير مباشرة، بحجّة أزمة السيولة، والتي جرى حلُّها جزئياً أخيراً، عبر كمية النقد التي أرسلتها روسيا، تنفيذاً لعقد سابق مع السلطة السابقة.
بين التيسير والتشديد النقديين
النظام السابق كان يعتمد منهجية عكسية، وهذا يعود في جزء كبير منه إلى استمرارية العمل ببقايا الهياكل الاشتراكية التي تهالَكَت كثيراً، مع احتفاظها بفاعلية ملحوظة، لجهة دعم الفئات الأكثر احتياجاً بين السوريين. السياسة النقدية المُتبَعة حينها كانت تقضي بإبقاء السيولة متوافرة في السوق بكمّيات كبيرة، عبر طباعتها باستمرار، في الخارج، حتى من دون تغطية فعلية من الذهب.
هذا كان يُبقي السيولة بالليرة في يد التجّار والمنتجين، وصولاً إلى الموظّفين والعمّال، حتى مع تراجُع الطلب على السلع والخدمات، نتيجة التضخّم القياسي والارتفاع المستمر في سعر الصرف. كان ذلك يترافق أيضاً مع عدم المساس بالكتلة الكبيرة من العمّال والموظّفين في القطّاع العامّ، إذ تدعم السياسة الخاصّة بالتيسير النقدي نظيرَتها المتعلّقة بإبقاء الدعم للطبقتين العاملة والمتوسّطة قائماً.
لم يكن ذلك كافياً لدعم الطلب على السلع والمنتجات، كون الطباعة المستمرّة للعملة تحفّز التضخّم بدلاً من السيطرة عليه، وهذا الأخير يكبح الطلب، ويُبقي الدعم الذي تَلقاه الطبقتان العاملة والمتوسّطة، عبر كتلة الأجور والرواتب، عند حدود معيّنة.
السياسة الانكماشيّة الحاليّة أنهت العمل بكلّ هذه المنظومة، ليس فقط عبر عَكْس السياسة النقدية الخاصّة بتصغير حجم السيولة ووضع سقوف على سحب الأموال من البنوك، بل أساساً عبر بلورة وجهة للاقتصاد تكون فيها الكتلة العاملة في مؤسّسات القطّاع العامّ أقلّ بكثير مما كانت عليه سابقاً، إلى درجة وصول أعداد المصروفين من وظائفهم إلى عشرات الآلاف من الموظّفين والعمّال.
خاتمة
اعتماد سياسة التشديد النقدي المعروفة بالتقشّف، في معظم الوجهات التي تقود الاقتصاد حالياً، بما في ذلك رفع الدعم عن المواد الأساسية وتركها للتنافسية السوقية وحدها، ينمّ، ليس فقط عن تبنٍّ للرأسمالية التي لا تقود إلى تراكم فحسب (كونها طَرَفية وتابعة)، بل كذلك عن منهجية واضحة لتفكيك ما تبقّى من هياكل اشتراكية موروثة عن الحقبة السابقة، حتى وهي تتهالك وتخضع لسيطرة الأوليغارشيا التي كانت تقود المرحلة الأخيرة من حكم بشار الأسد. الموقف المُعتمَد اقتصادياً بهذا المعنى، ليس في مواجهة النظام السابق، كونه تحوَّلَ إلى أوليغارشيا هو الآخر، بقدر ما هو نكوصٌ عن المكتسبات القليلة الباقية من الحقبة الاشتراكية، والتي لا يستفيد منها الأغنياء والأقلّية الأوليغارشية العابرة للنُظُم والحكومات، بل المهمّشون والفقراء والمياومون والعاملون بأجر. وهؤلاء يمثّلون، كما نعرف، الأكثرية العظمى من السوريين، سواءً في الموالاة السابقة، أو حتى في المعارضة السابقة، التي وصلت إلى السلطة حالياً.
* كاتب سوري
الاخبار
————————-
هل يحل تطبيق القرار 1680 أزمة الحدود اللبنانية السورية؟
مصدر وزاري: الحلول التقنية والأمنية تسبق المعالجة السياسية
بيروت: بولا أسطيح
20 مارس 2025 م
أعادت الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية مع سوريا، بين الجيش السوري ومقاتلي العشائر اللبنانية، الضوء إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في عام 2006 وحمل الرقم 1680، ولاحظ، بشكل أساسي، ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، كما أكد وجوب نزع سلاح الميليشيات.
جاء هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ القرار 1559، الذي صدر عام 2004، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وبعد مرور نحو 20 عاماً على صدور القرارين، لم ينفَّذا إلا جزئياً، وبالتحديد لجهة انسحاب القوات السورية من لبنان في عام 2005، وتبادل السفراء بين البلدين عام 2009.
واليوم، وبعد المواجهات المسلّحة التي اندلعت على الحدود الشرقية للبنان بين الجيش السوري ومجموعات من العشائر اللبنانية محسوبة على «حزب الله»، وُضع القرار 1680 مجدداً على طاولة البحث، علماً بأن القرار كان قد صدر في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، والذي أدى بشكل أو بآخر إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عاماً من الوجود العسكري السوري هناك. ورفضت سوريا، وقتها، القرار، وعَدَّته تدخلاً في شؤونها الداخلية، بينما رحّب به عدد من الدول الغربية والحكومة اللبنانية.
الوضع على الأرض
ووفق مصدر وزاري لبناني معنيٍّ بالملف، فإنه يجري حالياً حل الموضوع على المستويين الأمني والتقني، قبل الانتقال للمعالجة السياسية، وصولاً لترسيم الحدود، كاشفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الدفاع اللبناني هو الذي يتولى التواصل مع الإدارة في سوريا لحل المشكلة. وأوضح أن «الأزمة الحالية بدأت بإشكال بين مهرّبين، ومن ثم تطورت. والمشكلة الأساسية أنه من غير الواضح إذا ما كانت الجهة المركزية في سوريا متحكمة حقيقة بالأرض وبكل المجموعات المسلحة».
الكرة في ملعب سوريا
ويَعدّ رئيس مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري «أنيجما»، رياض قهوجي، أن «هذا القرار لم ينفَّذ بسبب رفض سوريا ومحور الممانعة؛ لأن ترسيم الحدود اللبنانية السورية جنوباً يُنهي موضوع مزارع شبعا، التي كان النظام السوري يرفض أي ترسيم يضع حداً للسجال حول لبنانية المَزارع أو عدمه. أما من ناحية الشمال فهناك حدود طويلة غير مرسّمة، والطرف السوري يستغل ذلك لإبقاء شبكات التهريب قائمة، وهو ما يستفيد منه تلقائياً (حزب الله)».
ويلفت قهوجي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «النظام السوري السابق كان يسعى لهيمنة تامة على لبنان والسيادة اللبنانية، لذلك لم يكن يريد ترسيم الحدود، كما أن الحكومات السورية المتعاقبة تاريخياً، وجزءاً كبيراً من الطبقة السياسية في سوريا، لم تكن تنظر إلى لبنان على أنه دولة مستقلة، إنما لديها شعور بأن لبنان جزء من سوريا وفُصل منها بـ(سايكس بيكو)». ويضيف: «أما إذا كانت الإدارة السورية الجديدة تسعى حقيقةً لتكون مختلفة عن سابقاتها وتتعامل بنِدّية مع لبنان، فعليها أن تقفل هذا الموضوع الذي يؤخر ملفات أساسية اقتصادياً. فترسيم الحدود البرية بين سوريا ولبنان سيُسهل ترسيم الحدود البحرية التي تسمح بتحديد أماكن المنطقة الاقتصادية التي تفتح الباب لشركات النفط والغاز للبحث في هذه المنطقة».
ويوضح قهوجي أن «ملف الترسيم طُرح في لقاءات عقدها مسؤولون لبنانيون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لكن لم تَعدَّها الإدارة الجديدة أولوية، لكن الأحداث الحدودية الأخيرة تُظهر أنها أولوية مُلحة، دون أن ننسى أن القرار 1680 كما القرار 1701 يُذكِّران بالقرار 1559، يدعوان لإنهاء وجود الميليشيات المسلّحة في لبنان، وهنا يأتي أيضاً دور (حزب الله) في منع تطبيق مثل هذا الاتفاق».
تدخُّل دولي؟
من جهته، يرى الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه «لم تكن هناك نية لدى سوريا، وتحديداً نظام الأسد، لتنفيذ القرار 1680. أما القيادة الجديدة فلم تتسلم بعدُ زمام البلاد والحدود بشكلٍ يسمح لها بتنفيذه». وعَدَّ، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تطبيق هذا القرار بحذافيره يمكن أن يشكل المدماك الأول في حل الأزمة الراهنة مع سوريا»، مضيفاً: «المطلوب من لبنان الرسمي مطالبة سوريا بتنفيذه، والمطلوب من سوريا الاستجابة، وفي حال عدم التجاوب بإمكان لبنان الاستعانة بالمجتمع الدولي وقوات الأمم المتحدة لتنفيذه، ووضع حد للانتهاكات الحاصلة راهناً على الحدود».
—————————
=====================
===========================
عن الأحداث التي جرت في الساحل السوري أسبابها، تداعياتها ومقالات وتحليلات تناولت الحدث تحديث 21 أذار 2025
تحديث 21 أذار 2025
——————————-
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
الأحداث التي جرت في الساحل السوري
—————————–
فرنسا «الساحل العلوي»: نوستالجيا الانتداب وابتذال الاستشراق/ صبحي حديدي
تحديث 21 أذار 2025
خلال مشاركته في مؤتمر المانحين حول سوريا، الذي احتضنته بروكسيل مؤخراً؛ ولكن، أيضاً، على صفحته الشخصية في منصة X ؛ كرّر وزير الخارجية الفرنسي جان ــ نويل بارو استخدام تعبير «الساحل العلوي» في إشارة إلى هجمات الفلول وأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والمجازر ضدّ أبناء الطائفة العلوية خصوصاً، التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخراً. ومن حيث المبدأ، أو التذرّع بحسن النوايا، في وسع المرء الافتراض بأنّ مساعدي الوزير الفرنسي (كي لا يُشار إلى واجب اطلاعه شخصياً على معطيات الحدّ الأدنى الديمغرافية حول المنطقة) قد أعلموه مسبقاً أنّ سكان ذلك الشطر من سوريا ليسوا علويين فقط، بل ثمة أطياف دينية ومذهبية وإثنية شتى، من سنّة ومسيحيين وتركمان وأكراد…
مصيبةٌ إذا كان بارو لا يعلم، أو لم يُعلمه مستشارون في وزارة ذات سجلّ حافل بفصولٍ عن سوريا البلد والشعب والجغرافيا، لا تعود بجذورها إلى إرث استعماري مُثقل بعقود من إراقة دماء السوريين وارتكاب الجيش الفرنسي مجازر وفظائع وانتهاكات فظة وجرائم حرب، فحسب؛ بل ينطوي تاريخها الحديث والمعاصر على ملفات شتى من التواطؤ مع نظام «الحركة التصحيحية» الأسد الأب ووريثه الابن معاً، والتغطية على منظومات الاستبداد والفساد، ومحاولات تجميل قبائح النظام وإعادة تأهيله. المصيبة أعظم إذا كان يعلم، أو أعلموه، لكنه فضّل التغافل عن العلم والمعلومة واختار استسهال هذا الطراز الفاضح من مسخ الصفة الفعلية الوطنية والديمغرافية التعددية لمنطقة الساحل السوري، إلى هوية طائفية ضيّقة من جهة أولى؛ ولا يغيب عنها، من جهة ثانية، مزيج من نوستالجيا استعادة مصطلحات الانتداب الفرنسي وتفاهة التشخيص الاستشراقي في آن معاً.
هذا، كما يقتضي إنصاف سجلات الخارجية الفرنسية (أو الـ«كاي دورساي» كما في التوصيف الاستعماري الأشدّ رسوخاً) وزير غرّ نصف جاهل/ نصف هاوٍ، أتى إلى الوزارة من بوابة حماقة كبرى ارتكبها رئيسه إمانويل ماكرون، حين حلّ الجمعية الوطنية ووضع فرنسا في مأزق حكومي لا يكفّ عن التفاقم. فإذا كانت تفوهاته حول «الساحل العلوي» زلّة لسان حمقاء في بروكسيل، فإنّ إصراره على استخدام التعبير ذاته على منصة X لن يفلح في منح عقله السياسي والدبلوماسي والمهني (سبق أن ترأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، كما شغل سابقاً وزارتَيْ التحويل الرقمي والاتصالات، وأوروبا) أدنى درجة من فضيلة الشك.
لكنه، من جهة ثالثة لا تقلّ مغزى، ليس غرّاً إلى درجة التغافل عن أضرار استخدام تعبير، خاطئ وحمّال إشكاليات عديدة وتحريضي واستفزازي، مثل «الساحل العلوي»؛ وبالتالي فإنّ من السذاجة الجنوح إلى تفسير الجهل أو انحطاط المعرفة أو زلّة اللسان، في قراءة إصرار بارو على استخدام التعبير تصريحاً في بروكسيل أمام محفل أوروبي ودولي، وتدويناً على منصّة يتابعها مئات الملايين في طول العالم وعرضه. وإذا عزّت مبررات الوزير في الحنين إلى أمثال جدّه الجنرال هنري غورو (المندوب السامي الفرنسي على سوريا ولبنان، الذي تقصد زيارة قبر صلاح الدين الأيوبي، وخاطبه هكذا: «استيقظ يا صلاح الدين. لقد عدنا. وجودي هنا يكرّس انتصار الصليب على الهلالـ«)؛ فلعلّه يحنّ إلى دور الانتداب الفرنسي في تأسيس ما أسمته باريس «دولة جبل العلويين» بين سنوات 1920 وحتى 1936، وشجعت تضافره على تقسيم سوريا مع دويلات دمشق وحلب وجبل العرب، وسلخ لواء الإسكندرون وضمّه إلى تركيا.
أم لعلّ بارو هذه الأيام تناهبه حنين إلى سَلَف له في أيام ماضية يدعى لوران فابيوس، سنة 2012؛ الذي اشتبك، في قاعة مجلس الأمن الدولي، مع بشار الجعفري مندوب النظام السوري آنذاك، حول علاقة بعض «وجهاء» العلويين بالانتداب الفرنسي. وهكذا أشار فابيوس إلى واقعة صحيحة تاريخياً: «بما أنك تحدثت عن فترة الاحتلال الفرنسي، فمن واجبي تذكيرك بأن جدّ رئيسكم الأسد طالب فرنسا بعدم الرحيل عن سوريا وعدم منحها الاستقلال، وذلك بموجب وثيقة رسمية وقّع عليها ومحفوظة في وزارة الخارجية الفرنسية، وإن أحببت أعطيك نسخة عنها».
ولأنه ينتمي إلى الـ«موديم» الحزب اليميني الذي يتلفع بأردية ليبرالية كاذبة، فلعلّ بارو اتكأ على تراث شاع في قصر الإليزيه، خلال عهود جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، وتولى مراراً سلسلة عمليات تجميلية أعادت تأهيل صورة الأسد الابن؛ بل بادر شيراك إلى منح قَتَلة صديقه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري المغفرةَ والترحيب معاً، مستأنفاً خطّ تعاطف مع نظام «الحركة التصحيحية» شمل الأب مثل الابن. ذاك عكس مزاجاً، سياسياً ولكن شخصياً أيضاً، جسدته حقائق أنّ شيراك كان الرئيس الغربي الوحيد الذي سار في جنازة الأسد الأب؛ كما كان المبادر إلى كسر عزلة الأخير الدولية، حين دعاه إلى زيارة باريس رسمياً في صيف 1998؛ وإلى إضفاء شرعية سياسية وأمنية على وجود قوّات النظام السوري في لبنان، خلال افتتاح القمّة الفرنكفونية في بيروت، سنة 2002.
من جانبه كان ساركوزي يواصل سياسةً في مراقصة طغاة الشرق الأوسط اعتمدها رؤساء فرنسا، سواء في العقود الأخيرة من عمر الجمهورية الخامسة في فرنسا، أم في عقودها الوسطى (أوّل زيارة للأسد الأب تمّت في عهد فاليري جيسكار ــ ديستان، 1976، بعد أشهر قليلة على دخول القوّات السورية إلى لبنان). فإذا كانت الأنشطة الدبلوماسية في العقود الأولى بمثابة تمرينات مبكّرة على ما ستطلق عليه التنظيرات الديغولية صفة «السياسة العربية لفرنسا» فإنّ خيار ساركوزي في الانفتاح على النظام السوري كان مدانياً لسلوك طبيعي، منتظَر وغير مستغرب البتة، من ذلك الرجل بالذات. الابتذال الاستشراقي تبدى أولاً في الزعم بأنّ العلاقة مع الأسد الابن هي امتداد «جغرافي» لوقوع سوريا على شواطئ المتوسط؛ الأمر الذي يلمّع انتداباً فرنسياً استعمارياً خضعت له سوريا، قبل أن يطوي صفحاته العنفية التي أراقت دماء السوريين في موقعة ميسلون صيف 1920، وقمع الثورة السورية الكبرى لعام 1925، ومذبحة حامية البرلمان السوري سنة 1945…
وظلّ حبراً على ورق ذلك النداء الذي وجهته إلى ساركوزي ثماني منظمات حقوق إنسان دولية (بينها «العفو الدولية» و«ميدل إيست واتش» و«الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان» و«الشبكة الأورو ـ متوسطية» و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»…)؛ وناشدته إيلاء اهتمام لوضع حقوق الإنسان في سوريا. أحد أسلاف بارو في الخارجية (برنار كوشنر، صاحب نظرية التدخّل الإنساني في الشؤون السيادية للدول) اكتفى بدسّ قصاصة في جيب وزير خارجية النظام وليد المعلّم، تضمنت لائحة بأسماء معتقلين سياسيين سوريين، سوف ستبتهج فرنسا بإطلاق سراحهم!
سلسلة الأضاليل، التي يشيعها خطاب بارو تتقاطع على نحو وثيق مع مقاربات حول سوريا الراهنة الجديدة باتت شائعة في بعض وسائل الإعلام الفرنسية، تنساق تلقائياً إلى استخدام تنميطات مشابهة، اختزالية وابتسارية يُستطاب توظيفها سريعاً ضمن سياقات العزف المتكرر على نغمة «الأقليات» و«المكوّنات». هي، إلى هذا، ليست بمنأى عن مغازلة تيارات اليمين المتطرف والعداء للإسلام عموماً والسنّي منه خصوصاً، حيث يخدم التوصيف الهوياتي المذهبي أو الإثني في تفتيت إجماع وطني متنامٍ، قبيل تصنيفه قسراً في هذه أو تلك من مقولات «التشدد» أو «السلفية» أو حتى «الإرهاب».
ولا عجب أن يصمت بارو عن انتقادات طالت تعبيره المغلوط الفاضح، فالقادم من الرجل قد لا يكون مماثلاً فقط، بل أعظم!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي
——————————-
سوريا… احتدام التنافس بين أجندات الخارج والداخل/ إبراهيم حميدي
ترمب يتوقع التقسيم وإسرائيل تريد “فيدرالية” وإيران تدفع إلى “التشظي”… والدول العربية تريد الاستقرار
19 مارس 2025
الرئيس دونالد ترمب قال في جلسة مغلقة، إن سوريا “ماضية إلى التقسيم لثلاث مناطق”. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث علنا عن “حماية الدروز”، وروج آخرون في حكومته لسيناريو “الفيدرالية”. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد دعم “وحدة سوريا” و”محاربة الإرهاب” ومنع قيام كيان كردي.
إيران، من جهتها، لم تقبل الهزيمة الاستراتيجية في سوريا. امتصت الصدمة وقررت التحرك فيها عبر “ثلاث جبهات”، فيما قبلت روسيا بتقليل خسائرها والبحث مع دمشق عن علاقات جديدة تتضمن استمرار وجودها العسكري ونفوذها في البلاد والإقليم.
أما الدول العربية والأوروبية، فقررت الانخراط مع الإدارة السورية الجديدة، لأن “دعمها أقل كلفة من أي بديل آخر”، وهي تريد الاستثمار في المكاسب الجيوسياسية، المتعلقة بخسارة إيران وروسيا، لأن أمن سوريا يتعلق بأمنها واستقرار الإقليم.
هذه خلاصة تقديرات ومعلومات من مسؤولين غربيين تحدثوا إلى “المجلة” خلال الأيام الماضية.
أميركا: التقسيم
في الأيام الأخيرة لإدارة جو بايدن، فتحت بابا للحوار مع الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتقت المسؤولة في الخارجية باربرا ليف، رئيس الإدارة أحمد الشرع في دمشق، وواصلت اتصالات غير معلنة قام بها دبلوماسيون أميركيون مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، كما خففت بعض العقوبات عن قطاعات سورية لمدة ستة أشهر.
منذ مجي إدارة دونالد ترمب، تشير المعلومات إلى وجود اتجاهين:
الأول، يرفض الانخراط مطلقا مع دمشق ويستند في موقفه إلى بُعد أيديولوجي يتعلق بـ”القاعدة”، أو تجارب شخصية تخص حرب العراق وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 أو بسبب علاقة شخصية مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مثل مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد. كما يرفض أصحاب هذا الرأي العمل مع الجيش السوري الجديد لمحاربة “داعش” ضمن التحالف الدولي وقيادة عملية “العزم الصلب”.
الثاني، مستعد لـ”انخراط مشروط” وفق مقاربة “خطوة مقابل خطوة”، عبر إقدام دمشق على سلسلة من خطوات تشمل: تشكيل حكومة جامعة، تشكيل جيش مهني حرفي، إبعاد المقاتلين الأجانب، تدمير برنامج السلاح الكيماوي والتدمير الشامل، محاربة “داعش”، التمسك بإبعاد إيران خارج سوريا، قطع طريق الإمداد إلى “حزب الله”، عدم الموافقة على استمرار وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين.
في المقابل، تعرض واشنطن استعدادها لخطوات تشمل تخفيف العقوبات على قطاعات محددة في شكل تصاعدي وصولا إلى رفع كامل للعقوبات و”قانون قيصر” في نهاية المطاف بعد حوالي أربع سنوات، علما أن قائمة العقوبات الأميركية تشمل “قانون قيصر” و”قانون محاسبة سوريا” و”دعم الإرهاب”، ويعود بعضها إلى عام 1979، إضافة إلى عقوبات فردية ضد مسؤولين في النظام السابق وشخصيات حالية أخرى.
سوريا ليست أولوية على أجندة ترمب. وتجري حاليا مراجعة داخل المؤسسات الأميركية وصولا إلى سياسة موحدة إزاء سوريا. ونُقل عن ترمب قوله في اجتماع خاص إن سوريا ستقسم إلى ثلاث مناطق تابعة لقوى خارجية مثل إسرائيل وتركيا وغيرهما، وإنه لا بد من محاربة “الإرهاب”، مع تلميح إلى إمكانية الانسحاب من شمال شرقي سوريا، الأمر الذي دفع وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى إعداد خطط للانسحاب في ستة أشهر، ودعمها بقوة لقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي للوصول إلى حل تفاوضي مع الرئيس أحمد الشرع خلال ذلك.
إسرائيل: فيدرالية
يراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التأثير على ترمب وفريقه، بحيث تكون حسابات تل أبيب ذات أولوية في البيت الأبيض الذي لا يدرج سوريا ضمن أولوياته في الشرق الأوسط. بالفعل، جرت مناقشات بين أجهزة إسرائيلية وأخرى أميركية حول هذا الملف، مع ترجيح رأي تل أبيب في شؤون جارتها.
نتنياهو يعتبر سوريا أولوية له هي والأمن القومي وإبعاد ايران. فالجيش الإسرائيلي قام بمجرد سقوط الأسد بتدمير جميع الأصول العسكرية الاستراتيجية السورية، البرية والجوية والبحرية والبرامج العلمية والصاروخية. كما احتل المنطقة العازلة في الجولان بموجب اتفاق “فك الاشتباك” لعام 1974. وسيطر على قمة جبل الشيخ ومنابع المياه في المنطقة. وشن سلسلة غارات في جنوب سوريا ووسطها لمنع بناء أصول استراتيجية دفاعية سورية.
إضافة إلى ذلك، تتخذ إسرائيل موقفا عدائيا ضد الحكم السوري الجديد، وهي تدفع باتجاه إقامة “فيدرالية” أو “لامركزية واسعة” في سوريا، تشمل إقليما جنوبيا يتضمن السويداء ودرعا، وشرقيا يشمل “قوات سوريا الديمقراطية”، وغربيا يتضمن إقليما علويا، بحيث يبقى الإقليم العربي-السني الأكبر معزولا عن جواره وفضاءات المياه الدافئة.
جرت اتصالات سرية حول هذه الأمور في واشنطن وعواصم إقليمية. ويدفع نتنياهو بقوة لإقناع ترمب وفريقه بهذا التصور، الذي هو موضع قلق عربي وتركي ومواكبة إيرانية غير مباشرة ومتابعة روسية، كما هو محل مواكبة أوروبية مع ترجيح للمقاربة البريطانية.
روسيا: تقليل الخسائر
عندما أدرك الرئيس فلاديمير بوتين قرب نهاية بشار الأسد الذي تمرد مرات عدة على طلباته- وكان آخرها رفضه لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بناء على مبادرة الكرملين- رتب مع نظيره التركي الانخراط في الأيام الأخيرة من نظام الأسد لتقليل الخسائر الروسية الاستراتيجية وتجنيب دمشق والموالين للنظام الخراب والانتقام.
بالفعل جرى الانتقال بأقل كلفة للمدن والبشر والموالين للنظام، ولم تتعرض القاعدتان الروسيتان، في حميميم وطرطوس، لأي هجمات من النظام السوري الجديد. كما صدرت تصريحات من المسؤولين السوريين الجدد تتحدث عن العلاقة القديمة مع روسيا واحترام مصالحها باعتبارها دولة كبرى.
زار ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي دمشق والتقى الرئيس الشرع الذي تلقى اتصالا معلنا من بوتين وآخر غير معلن. تتناول المحادثات السورية–الروسية نقاطا عدة: التزود بالسلاح الروسي، تسلم بشار الأسد وكبار المسؤولين المتهمين بجرائم حرب، مستقبل القاعدتين الروسيتين، المساهمة في إعمار سوريا، تقديم المساعدات والأموال السورية المطبوعة تعويضا عن مساهمة روسيا في قمع الشعب السوري، الديون الروسية لسوريا.
بوتين أبلغ دمشق رسالة واضحة بأنه لن يسلم الأسد إلى دمشق، لأنه “قال كلمته وقدم له لجوءا إنسانيا”، كما أنه لم يقبل فكرة أن “ينتحر الأسد على الطريقة الروسية”، لكن موسكو أبدت انفتاحا لتقديم السلاح والمساهمة في الإعمار وسحب قواتها “فورا إذا أرادت دمشق”. كما أبدت دمشق انفتاحا لبحث وجود عسكري روسي في سوريا. والمفاوضات جارية وتتناول هذه البنود والمقايضات.
في هذا السياق، حصل تطوران: الأول، أن تل أبيب سعت لدى واشنطن لتأييد استمرار الوجود الروسي لـ”موازنة النفوذ التركي” في سوريا. والثاني، تمرد فلول النظام السوري في الساحل، حيث اتخذت موسكو موقفا يسمح لها باستخدام هذا التمرد ورقة ضغط على دمشق وورقة تسمح لها بترك الخيارات مفتوحة في حال أقيم إقليم علوي.
إيران: التشظي
لم تقبل طهران الواقع الجديد بفقدان سوريا بعد لبنان، فهي خسرت طريق الإمداد إلى “حزب الله”، والحديقة الخلفية للعراق، وأداة الضغط على إسرائيل عبر جبهتي لبنان وسوريا. كل المؤشرات تشير إلى تفضيل إيران خيار “التشظي السوري” والرهان على الوقت، لاستعادة موطئ قدم في سوريا. عليه، بدأت في الفترة الأخيرة بعد اجتماعات سرية عدة تحريك أوراقها لفتح ثلاث جبهات:
الأولى، استعادة علاقات مع مسؤولين في النظام السوري السابق كان بينهم العميد غياث دالا، الذي كان يقود “قوات الغيث” في “الفرقة الرابعة” بقيادة اللواء ماهر، شقيق بشار الأسد، وكان ضابط الارتباط مع “الحرس” الإيراني و”حزب الله”. ماهر الأسد نفسه هرب مع قادة ميليشيات تابعة لإيران في 8 ديسمبر/كانون الأول إلى العراق، وقيل إنه انتقل إلى السليمانية في كردستان العراق. ومن غير المؤكد مكان وجوده الحالي. كانت أيادي إيران واضحة في تمرد الساحل الأخير، بالدعاية والتدريب والمعلومات.
الثانية، الضغط على “الحشد الشعبي” العراقي للتحرك نحو الحدود السورية. وإيران تريد تعزيز وجودها في العراق بعد خسارات “الهلال” في بلاد الشام، وتريد استخدامه في الملعب السوري. أيضا، يجري تداول سيناريو عودة “داعش” للنشاط في الأنبار وغربي العراق والتوغل نحو البادية السورية.
الثالثة، الضغط على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وتحريك عشائر عربية شرق الفرات، للتنسيق والعمل العسكري ضد الإدارة السورية الجديدة. قائد “قسد” نفى ذلك في حديثه إلى “المجلة”. وقال: “لن يكون هناك مستقبل لعلاقات مع إيران. ونحن حاليا نركز على أن نكون جزءا من الإدارة الجديدة وجزءا من المحادثات السياسية لا أن نكون معارضة كما يتهمنا البعض”. كما وقع اتفاق مبادئ مع الرئيس الشرع في دمشق يوم 10 مارس/آذار بعد جهود أميركية وفرنسية مكثفة.
تركيا: مع الوحدة ضد كيان كردي
لم يكن أردوغان مرتاحا كثيرا لاتفاق الشرع-عبدي. الاتفاق كان موجودا على طاولتيهما منذ لقائهما في 29 ديسمبر، لكن تمرد الساحل والانتهاكات فيه من جهة، وحديث الأميركيين السري عن احتمال الانسحاب بعد ستة أشهر من جهة ثانية، وتفاهم زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبدالله أوجلان مع أنقرة من جهة ثالثة، دفعت الشرع وعبدي لتلبية جهود أميركية-فرنسية، وتوقيع اتفاق يحتاج تنفيذه إلى الكثير من التفاوض وخريطة طريق، هي في قبضة مساعديهما. مظلوم حق نجاحا بأنه “فتح باباً رئاسياً لمناقشة حقوق الأكراد لأول مرة في التاريخ”. والشرع، فتح باباً سورياً لحياكة الخريطة السورية بعد أكثر من عقد من التآكل.
تركيا تدفع إلى تنفيذ مبادئ الشرع-عبدي، وهي: منع وجود “الإدارة الذاتية” وأي كيان كردي، وانضواء شمال شرقي سوريا ضمن سوريا الموحدة، وتفكيك البنية العسكرية الثقيلة لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية، وطرد قادة “حزب العمال الكردستاني” الموجودين في قيادة “الوحدات”.
وتسعى تركيا للإفادة من علاقتها مع “هيئة تحرير الشام” والشرع للدفع باتجاه تعزيز نفوذها في سوريا والإقليم في النواحي التجارية والعسكرية والسياسية والجيوسياسية. فسوريا تاريخيا بوابة تركيا إلى العالم العربي. لكن هذا النفوذ هو مصدر قلق لدول أخرى بينها دول عربية فاعلة.
الدول العربية: استقرار سوريا ووحدتها
منذ سقوط الأسد، بادرت دول عربية كبرى لدعم النظام الجديد وفتح صفحة جديدة معه، لأسباب عدة، بينها: البناء على الخسارة الاستراتيجية الأكبر لإيران منذ 1979. تخفيف اعتماد النظام السوري الجديد على تركيا. الحوار والانخراط والدعم لسوريا الجديدة وإعطائها الفرصة، لأن البديل سيئ جدا، والفوضى في سوريا مضرة والتقسيم خطير على الدول المجاورة والأمن الإقليمي العربي.
اكتشفت دول عربية حدود التحرك والدعم. لا يزال سيف العقوبات مسلطا. أميركا وافقت على تسهيل إمداد سوريا بالغاز لصالح توفير الكهرباء وسمحت بصفقة تتضمن مقايضة إعفاءات مقابل الوصول إلى السلاح الكيماوي السوري، لكنها لا تزال ترفض السماح بتحويلات مالية كبرى والانفتاح على النظام المصرفي السوري. هناك إصرار على ترك هامش الوقت لدمشق وتقديم النصيحة وليس الضغط والتحاور مع واشنطن ودول أوروبية لاعتماد أفضل الخيارات الواقعية حاليا في سوريا.
الأجندة السورية وجرس الإنذار
ما حصل في الساحل السوري بين 6 و10 مارس/آذار، سواء التمرد أو الانتهاكات الكبيرة، كان بمثابة جرس إنذار. فقد أظهر أهمية المفاجأة التي حصلت في 8 ديسمبر، إذ سقط نظام الأسد بعد 54 سنة من دون كلف دموية كبيرة بفضل التزام العناصر في “هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى بتعليمات القيادة العليا.
لكنه أظهر في الوقت نفسه، أسئلة حول سلسلة القيادة من فوق إلى أدنى، ومدى التزام المقاتلين أو الفصائل بالتعليمات، وطرح أسئلة في عواصم أوروبية عن “حماية الأقليات”، ودفع باريس إلى تأجيل توجيه دعوة لزيارات رفيعة لمسؤولين سوريين وعواصم أخرى لتجميد إعادة فتح سفاراتها لأسباب أمنية. إضافة إلى ذلك، كان بمثابة ناقوس خطر لما يمكن أن يحصل في حال عمت الفوضى. فتشظي سوريا يعني تطاير الشظايا والجهاديين في الإقليم وما وراءه.
برزت مشكلة تسريح عناصر الجيش والأمن والشرطة وموظفي القطاع العام، وتوفير الخدمات والكهرباء. فأصبح الملف الاقتصادي الاجتماعي أولوية للحكم الجديد. فالعقوبات لم ترفع والمساعدات الدولية تراجعت والتوقعات الشعبية زادت. قد يكون أحد الحلول طبع أموال جديدة، وتنفيذ هذا في موسكو. قد يكون الرمق في مساعدات عاجلة، لكنها قليلة طالما أنها عينية مرتبطة بالنظام المصرفي الغربي. ولا تزال الجالية السورية وحلفاء دمشق العرب والإقليميون، يعملون لدى واشنطن لرفع العقوبات وتخفيف معاناة الناس، لأنه دون ذلك، فإن تأثير رفع العقوبات الأوروبية والبريطانية والكندية سيكون محدودا جدا.
وأظهر المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل يوم 17 مارس/آذار، الدعم الأوروبي المستمر للسوريين، حيث أعلن عن تعهدات مالية بقيمة ستة مليارات دولار أميركي. فمنذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 37 مليار يورو من المساعدات داخل البلاد وفي المنطقة.
لكن الأهم أن المؤتمر أظهر، أن دعم الحكم السوري الجديد سيكون أقل كلفة من أي خيار آخر، بما في ذلك خيار عزله. وواصلت فرنسا جهودها لحشد المجتمع الدولي، تماشيا مع مؤتمر باريس في 13 فبراير/شباط، لإيجاد حلول دائمة وتوفير الاحتياجات الأساسية. كما جددت رسالتها إلى السلطات السورية بضرورة محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن العنف ضد الضحايا المدنيين في الأسابيع الأخيرة.
مقابل الأجندات الخارجية، هناك أجندة سوريا وخيوط سورية. وباعتبار ما حدث في الساحل كان جرس إنذار واختبارا كبيرا، فإن الشرع رد عليه بسلسلة خطوات برغماتية انفتاحية تمثلت في تشكيل لجنة تحقيق ولجنة للسلم الأهلي وإعلان دستوري. هناك انقسام حول هذه الخطوات. البعض قابله بالترحيب، فيما شكك آخرون فيها وطرحوا أسئلة عن ضرورة أن تكون الخطوات جامعة وأن تكون الخطوط مفتوحة في الاتجاهين بين المركز والأطراف.
أجندة دمشق هي رفض التقسيم ورفض الفيدرالية والعمل على بناء جيش وطني وحكومة ومؤسسات دولة وتعميم السلم الأهلي. واتفاق الشرع–عبدي، كان يعني في أحد جوانبه، إعطاء أولوية للأجندة الوطنية. هناك خطوات منتظرة ومتبادلة بين المركز وجهات الجنوب والشمال والغرب، لقطع الطريق على الأجندات الخارجية المتنافسة. وهناك أجندات خارجية متنافسة على مستقبل سوريا. عمليا، يحتدم الصراع بين أجندات الخارج وأجندة الداخل، ولكل أدواته وتحالفاته وإمكاناته ومواقيته.
المجلة
——————————-
6 عوامل أفشلت الانقلاب في سوريا/ كمال أوزتورك
19/3/2025
لم ترشح رواية رسمية مفصلة عما جرى في سوريا في 8 مارس/ آذار 2025، ومع ذلك فقد كانت تلك الأحداث التي شهدها الساحل السوري في جوهرها “محاولة انقلاب”.
تذكروا أن العمليات الإرهابية التي بدأها جنود سابقون من جيش الأسد في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة سرعان ما تحولت إلى اشتباكات في أماكن متعددة.
هذه المواجهات، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، أثارت ردود فعل قوية على مستوى الرأي العام العالمي، وخاصة في تركيا وأوروبا وأميركا، حيث انطلقت حملة تحت شعار: “العلويون يرتكبون مذابح”، مما دفع الولايات المتحدة وروسيا إلى دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ.
لكن الأحداث لم تتوقف عند هذا الحد. في شمال حلب، خرج مسلحو قوات سوريا الديمقراطية YPG وحزب العمل الكردستاني PKK من مواقعهم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرتهم، وهاجموا قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الجديدة. شهدت هذه المناطق اشتباكات عنيفة، ونتج عن ذلك اضطرابات كبيرة داخل المدينة.
وفي الوقت نفسه، بدأت المليشيات الشيعية داخل العراق، إلى جانب الجماعات الكردية شبه العسكرية القريبة من PKK، في التحرك، لكن الحكومة العراقية وتركيا منعتا دخول هذه الجماعات إلى سوريا.
وبمرور الوقت، أصبح من الواضح أن هذه الأحداث لم تكن مجرد اضطرابات عشوائية، بل كانت جزءًا من مخطط منظم يهدف إلى الإطاحة بالحكومة السورية، وذلك من خلال تحركات منسقة بين بقايا جيش الأسد وقوات سوريا الديمقراطية YPG.
وكان من يقف وراء هذا المخطط، إسرائيل، وبدرجة أقل، إيران. لكن هذه المحاولة فشلت.
إذن، كيف حدث ذلك؟
لماذا فشلت محاولة الإطاحة بالحكومة في دمشق؟
سبق أن كتبت هنا أن إسرائيل، في إطار إستراتيجيتها لزعزعة استقرار سوريا، حاولت خلق فوضى عبر استغلال الأقليات الدرزية والعلوية والكردية.
لكن الدروز لم يكونوا جزءًا من هذا المخطط. بل على العكس، أعلن زعيمهم في لبنان وليد جنبلاط، إلى جانب العديد من العائلات الدرزية، وقوفهم إلى جانب الحكومة السورية.
في المقابل، انسحبت بعض المجموعات من الجنود السابقين لجيش الأسد إلى العمل السري داخل المناطق العلوية، حيث نظمت نفسها بانتظار اللحظة المناسبة للهجوم على الحكومة. وكان من الواضح أن هذه الجماعات تلقت تحفيزًا من إيران.
يُعتقد أن التحذير الصارم الذي وجهه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لإيران بعدم التدخل في الشأن السوري كان يستند إلى معلومات استخباراتية تلقتها أنقرة حول استعداد بقايا جيش الأسد وقوات YPG لتنفيذ هجمات.
أما رفض قوات سوريا الديمقراطية YPG المرتبطة بحزب العمال الكردستاني دعوة عبدالله أوجلان لإلقاء السلاح، فقد كان بإيعاز من إسرائيل، حيث استغل التنظيم الاضطرابات التي بدأت في اللاذقية وطرطوس ليشن هجمات على قوات الأمن التابعة للحكومة السورية في حلب، ليكون جزءًا من المخطط الأوسع للإطاحة بالحكومة.
لو نجحت هذه الخطة، لكانت دمشق قد دخلت في حالة من الفوضى، وكان من الممكن أن تمتد الاضطرابات إلى العاصمة، مما كان سيؤدي إلى سقوط حكومة أحمد الشرع، مدعومًا ذلك بتدخلات من قوى أجنبية.
وكانت النتيجة التي يهدف إليها المخطط هي إقامة دولتين جديدتين في سوريا: دولة علوية على الساحل، ودولة كردية بقيادة YPG في الشمال. هذه الخطة كانت جزءًا من المشروع الإسرائيلي المعلن لتقسيم سوريا، كما أنها كانت تتماشى مع المصالح الإيرانية.
أما روسيا، فقد فضلت البقاء في موقف المراقب، في انتظار معرفة من ستكون له الغلبة قبل أن تحدد موقفها النهائي.
لكن هذا المخطط لم ينجح، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب:
1- التحالف التركي-السعودي أفشل المخطط
حظيت الحكومة السورية الجديدة بدعم قوي من اثنتين من أقوى دول المنطقة. عندما قدمت تركيا والمملكة العربية السعودية دعمًا قويًا لحكومة أحمد الشرع، انضمت إليهما دول أخرى ضمن نفس التحالف.
مع بداية الأحداث، حلّقت الطائرات الحربية التركية فوق الحدود العراقية- السورية، مما منع المجموعات الكردية والمليشيات الشيعية شبه العسكرية التي كانت تحاول العبور إلى سوريا.
وبعد يومين فقط من اندلاع المواجهات، زار كل من وزير الخارجية التركي، ووزير الدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MİT) دمشق، ليعلنوا مجددًا دعمهم العلني للحكومة السورية.
من جانبها، أعلنت السعودية وقوفها إلى جانب الحكومة السورية، كما ضمنت دعم القبائل العربية والجماعات المدعومة من الأردن لصالح دمشق. وكان لهذا الدعم التركي والسعودي الدور الأكبر في إفشال المحاولة الانقلابية.
2- نجاح الحكومة السورية في إدارة الأزمة
بعد اندلاع الأحداث في اللاذقية وطرطوس، تابع أحمد الشرع بجدية الادعاءات التي تفيد بأن المدنيين تعرضوا للأذى، وبدلًا من إنكار هذه الادعاءات، قام على الفور بتشكيل لجنة وفتح تحقيقًا رسميًا، وهو ما كان نقطة تحوّل هامة.
كما تمكنت الحكومة من السيطرة على بعض الجماعات التي خرجت عن السيطرة وألحقت أضرارًا بالمدنيين، حيث تم اعتقال عناصرها، مما أدى إلى طمأنة الأقلية العلوية بشأن سلامتها، وأحبط أي محاولة لتحويل الأزمة إلى حرب أهلية. وقد ساهمت هذه الإجراءات أيضًا في تهدئة الرأي العام العالمي.
3- تأثير اتفاق عمّان
قبل يوم واحد فقط من اندلاع الأحداث، اجتمعت كل من تركيا وسوريا والعراق ولبنان والأردن في عمّان، حيث أعلنت للمرة الأولى عن إنشاء هيكل مشترك لمكافحة تنظيم الدولة.
وقد لقي الإعلان عن أن أربع دول مجاورة لسوريا ستؤسس مركز عمليات داخل البلاد لدعم الحكومة السورية صدى واسعًا في المنطقة.
إلى جانب ذلك، أعلنت هذه الدول عن تعاونها في مجال أمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتصدي للإرهاب، مما مثل دعمًا كبيرًا لسوريا.
استوعبت كل من إيران وإسرائيل هذه الرسالة، كما أدركت القوى التي تعمل بالوكالة داخل سوريا أن قنوات دعمها الخارجية ستنقطع قريبًا، وهو ما شكل تأثيرًا نفسيًا ساهم في إحباط المحاولة الانقلابية.
4- التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة
أدى قيام الإدارة الأميركية بمفاوضات مباشرة مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي رد فعل علني على الانتقادات الإسرائيلية، وقبل أن يتم عزله لاحقًا، قال المبعوث الخاص الذي عيّنه ترامب لشؤون الأسرى في غزة، آدم بوهلر، في تصريح لشبكة CNN: “نحن لسنا عملاء لإسرائيل؛ لدينا مصالح محددة، وقد تواصلنا مع حماس بناءً على هذه المصالح”.
وفي حديث لصحيفة وول ستريت جورنال، قال مسؤول أميركي: “لقد بذلنا جهدًا من أجل تحقيق تقارب بين الأكراد والحكومة السورية”، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تتصرف بشكل معاكس لسياسة إسرائيل التي تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا. وهذه المؤشرات كانت تدل على وجود خلافات واضحة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وعندما فشلت المحاولة الانقلابية، التقى قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الجنرال مايكل إريك كوريلا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (SDF) مظلوم عبدي، ثم نقله على متن مروحية أميركية إلى دمشق، حيث تم ترتيب لقائه مع أحمد الشرع للتوصل إلى الاتفاق الشهير بين الطرفين.
في الواقع، لم يكن هذا الأمر يروق لإسرائيل، لأن هذا الاتفاق كان يساهم في استقرار سوريا، وهو ما لا يخدم المصالح الإسرائيلية.
5- الواقع الجيوسياسي
الأمر الذي لم تستوعبه إسرائيل والفصائل المدعومة من الولايات المتحدة، هو أن الواقع الميداني في سوريا، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية الجديدة، لم يعد يسمح لهما بتنفيذ العمليات التي كانتا تخططان لها بسهولة.
فتركيا، التي تمتلك قوة عسكرية كبيرة داخل الأراضي السورية والتي دفعت PKK إلى إطلاق نداء بإلقاء السلاح، ازدادت نفوذًا بعد تراجع الدور الإيراني في الساحة السورية. إلى جانب تركيا والسعودية، تدعم قطر وعدد كبير من الدول الإقليمية الحكومة السورية، وترفض أي عمليات عسكرية تهدف إلى زعزعة استقرارها. كما أن خمس دول مجاورة لسوريا شكلت تحالفًا وأعلنت دعمها للحكومة السورية.
كل هذه العوامل تشير إلى أن الواقع الجيوسياسي قد تغير بشكل جذري، ولذلك فإن تنفيذ انقلاب داخل سوريا لم يعد أمرًا سهلًا كما كان يُظن.
6- الصراع الأوروبي-الأميركي
أثرت الحرب التجارية التي بدأها ترامب مع أوروبا على التوازنات الإقليمية أيضًا، حيث بدأت أوروبا في التقارب مع تركيا، كما بدأت في معارضة السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة وإسرائيل في كل من سوريا وغزة. عارض الاتحاد الأوروبي علنًا تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، كما أصدر بيانًا بشأن الاضطرابات في سوريا جاء متطابقًا تقريبًا مع الموقف التركي، حيث قال:
“يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها عناصر من بقايا نظام الأسد ضد قوات الحكومة المؤقتة، وأعمال العنف ضد المدنيين في المناطق الساحلية السورية”.
كان هذا التصريح بمثابة دعم واضح للحكومة السورية الجديدة. وبعد الإعلان عنه، أصيبت الجاليات الكردية والعلوية في أوروبا بخيبة أمل، إذ لم تتمكن من تشكيل رأي عام أوروبي داعم لمطالبها.
كما أن هذا التصريح كان مؤشرًا على أن أوروبا لم تعد مستعدة لدعم كل ما تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل فرضه في المنطقة. كل هذه العوامل أدت إلى فشل المحاولة الانقلابية في سوريا.
لكن هناك حقيقة أخرى لا يمكن تجاهلها: الشعب السوري بات يدعم حكومة أحمد الشرع، وقد أنهكته الحروب ولم يعد يريد سوى الاستقرار.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وصحفي تركي
الجزيرة
—————————-
ما مصلحة إيران من إشعال حرب طائفية في سوريا؟/ فراس فحام
2025.03.20
تواترت التسريبات التي تشير إلى تورط إيران في أحداث الساحل السوري التي اندلعت بداية آذار الجاري، حيث تفيد المعلومات التي رشحت أن 3 غرف عمليات شاركت في تسهيل هجوم فلول الأسد على مواقع الأمن السوري في الساحل، إحداها موجودة في العراق، والثانية في الرقة، والثالثة في الهرمل على الحدود السورية اللبنانية.
ومن قبل المواجهات في الساحل السوري التي أودت بحياة مدنيين أيضاً، عملت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من لبنان والعراق على التحريض، وتقديم سردية تدعي أن العمليات الأمنية التي ينفذها الجيش السوري ضد فلول الأسد على أنها حرب تستهدف الطائفتين العلوية والشيعية.
تعاملت إدارة العمليات العسكرية التي قادت المواجهات ضد نظام الأسد بحساسية عالية تجاه العراق، حيث وجه قائد العمليات أحمد الشرع خلال المعارك التي اندلعت في كانون الثاني الماضي رسائل للجانب العراقي، أكد فيها الحرص على علاقات جيدة مع دول الجوار، كما سُهلت عودة سكان بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين شمالي حلب إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات وحمايتهم من أي انتهاكات، مع منع الاقتراب من المزارات الدينية الشيعية.
هذا السلوك من الجانب السوري قوى موقف الحكومة العراقية التي تتبنى الانفتاح على سوريا، وسحب الذرائع من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي بقيت إلى ما قبل زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد منتصف الشهر الجاري تعارض إقامة علاقات مع سوريا، تجسيداً للرؤية الإيرانية.
ولا تزال طهران ترغب في استخدام الأراضي العراقية من أجل زعزعة الاستقرار في سوريا، ووفق ما رشح من معلومات فإن وزير الخارجية السوري طالب بغداد بعدم السماح لإيران بالاستمرار في توظيف أطراف عراقية لعرقلة تطوير العلاقات العراقية السورية.
تمارس إدارة ترمب ضغوطات كبيرة من أجل نزع سلاح الأذرع الموالية لإيران في العراق ولبنان، ويطالب ترمب بحل فصائل “الحشد الشعبي”، أو دمجها ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، في ظل معارضة طهران لهذا الخيار الذي سيؤثر بشكل كبير على نفوذها في الساحة العراقية التي تتعامل معها طهران على أنها منصة للتهرب من العقوبات، وساحة مناورة سياسية وعسكرية لتحقيق مصالح إيرانية.
من جهة أخرى، تشهد الساحة اللبنانية منذ عدة أشهر نقاشات حول مستقبل سلاح “حزب الله” اللبناني، والدعوة لتولي الجيش اللبناني مهمة بسط الاستقرار.
استمرار التوتر الطائفي في سوريا، وحصول اشتباكات على الحدود العراقية السورية، أو السورية العراقية كما حصل مؤخراً في الهرمل بعد تسلل عناصر من “حزب الله” إلى الأراضي السورية، يقوي خيار تمسك الحزب والفصائل العراقية المتحالفة مع إيران بسلاحهم، وعرقلة عملية احتكار الدولتين العراقية واللبنانية فقط للسلاح.
لا يبدو أن هذا التوقيت مناسب لإيران بما يتعلق بتفكيك الأذرع المسلحة المرتبطة بها في المنطقة، خاصة وأنها ترفض مطالب ترمب بالعودة إلى الاتفاق النووي لكن تحت الضغوطات الاقتصادية والسياسية، وتفكيك الفصائل الموالية لها يعني تجريد طهران من ورقة ضغط وقبل الجلوس على طاولة المفاوضات.
وطوال فترة التصعيد بين إيران وإسرائيل خلال عامي 2023 و2024، اعتمدت طهران على أذرعها العراقية واللبنانية في تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لتهديد أمن إسرائيل، ويبدو أن طهران تتخوف من موجة تصعيد جديدة ضدها، حيث تحلق طائرات استطلاع أميركية في الآونة الأخيرة قرب الحدود الإيرانية، وبالتالي فمن الطبيعي أن تدفع طهران باتجاه استمرار هذه الأذرع المسلحة.
تلفزيون سوريا
—————————–
سوريا وتجاوز ثنائيّة الأكثريّة والأقليّة!/ حسن المصطفى
سوريا اليوم في حاجة لأن تتجاوز فكرة ثنائية: العربي والكردي، المسلم والمسيحي، السني والشيعي، وألّا تنظر إلى الدروز والعلويين كأقليات، بل على الدولة الوطنية أن تكون حاضنة للجميع.
17-03-2025
لا يزالُ مفهوم “المواطنة” ملتبساً في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية، كون هذه المجتمعات لا تزال في حالة هجينة، لم تنتقل فيها تماماً إلى الدولة الوطنية الحديثة الناجزة، رغم أن عدداً منها مرت عليه عقود طويلة على الاستقلال، وجزء رئيس من هذا الخلل يعود إلى المنظومة المعرفية الهشة التي شُيدت عليها الأنظمة أو السياسات.
ثمة مفاهيم فلسفية أساسية تدخل في حقل “الفلسفة السياسية”، وهي بمثابة القاعدة الصلبة التي تشيد عليها مؤسسات الدولة، وتوزع وتفصل من خلالها السلطات، وتنتظم العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وأيضاً تُشكل الإطار المفاهيمي للدستور.
“المواطنة الشاملة” هي واحدة من أهم تلك المفاهيم، وهي إذ تحضرُ اليوم في الفضاء العربي – الإسلامي، فهي لا تُطل بوصفها قيمة ترفية، بل ركن ركين من دونه لا يمكن لمدماك الدولة الوطنية أن يستقر.
من تابع الأحداث الدموية والمواجهات العسكرية وعمليات التمرد والقتل والانتقام التي جرت في الساحل السوري، أخيراً، وراح ضحيتها أبرياء ومدنيون كثر – من دون الدخول في الجدل السياسي والغرق في وحول الإشاعات والمعلومات المضللة التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي – سيجد أن ما جرى يشير إلى قصور في فهم معنى “المواطنة” وإدراك كنهِها لدى شريحة واسعة من السياسيين والجمهور العام!
“المواطنة الشاملة” تعني في أبسط صورها أن الأفراد والجماعات في أي دولة، هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وأنه لا يجوز التمييز بينهم لأسباب عرقية أو دينية أو مناطقية، وهم بذلك لهم الحق في الحصول على فرصٍ متساوية، سواء في التعليم أم في العمل أم في الطبابة وسواها، وأيضاً يستطيعون التعبير عن ذواتهم الخاصة أو الجمعية، بشكل حرٍ ومن دون إكراهات.
هذا يقودنا بالتالي إلى أمرٍ يتجاوز المفهوم السائد لـ”الحقوق”، والقائم على تصورٍ منقوصٍ لـ”الديموقراطية” التي يتصور البعض أنها تعني حكم الأكثرية، وبالتالي يحق لهذه الأكثرية أن تضع ما تشاء من قوانين طالما كان ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها، وبقوة تصويت الأغلبية وتأييدها!
هذه النزعة فيها شيء من الاستعلاء وأيضاً يشوب ممارستها خللٌ كبير، لأنها سوف تنتهك مفهوم “المواطنة الشاملة” الذي يتجاوز التقسيمات القديمة: أكثرية وأقلية.
هذا التقسيم، يخلق تقابلاً يدفع نحو الصراع، وهو يتجاوز المنافسة السياسية إلى المناكفة وفرض ثقافة أعلى على أخرى أدنى!
وعليه، من الممكن أن يقود تقابلُ “الأكثرية” و”الأقلية” إلى تعميق القلق الاجتماعي وزرع بذور الريبة والشك المتبادل.
إن المجتمعات الحديثة في أوروبا على سبيل المثال، بنيت على مفهوم “المواطنة الشاملة”، وبالتالي تم تجاوز الثنائيات المتصارعة، لأن الجميع مواطنون، لهم هوياتهم الفرعية الخاصة، ولهم الحق في إبراز ثقافاتهم ومعتقداتهم، إنما ليس هنالك حق لأكثرية أن تضطهد أكثرية، ولا يمكن للأقلية أيضاً أن تتمرد على الأغلبية، لأن “المواطنة” تجعل المكونات المتجاورة محكومة بـ”القانون العادل” وتحت سقف الدولة المدنية.
سوريا اليوم بحاجة لأن تتجاوز فكرة ثنائية: العربي والكردي، المسلم والمسيحي، السني والشيعي، وأن لا تنظر إلى الدروز والعلويين كأقليات، بل على الدولة الوطنية أن تكون حاضنة للجميع، قادرة على تقديم خطاب وطني ترى فيه كل هذه المكونات ذاتها من دون انتقاص أو تضخم، ويفتح الطريق أمام بناء الدولة الحديثة وتنميتها.
هنالك واقعٌ صعب ومعقد في مجتمع عانى من حكم استبدادي طوال عقود خلت، وهو لا يزال لم يتداو من جراح الأحداث الدامية ما بعد عام 2011 وما جرته من مجازر وحروب أهلية؛ إلا أن هذا الإرث الثقيل من الوجع والعذابات يجب أن يكون حافزاً لبناء “مواطنة حقيقية” لا صورية، وأن يدرك الجميع أن الدم والثأر والكراهية والانتقام، كل هذه هي وصفات جاهزة للخراب الذي سيكون الجميع فيه خاسرون.
هذا الوعي المفاهيمي لا يمكن أن يحصل بين عشية وضحاها، بل لا بد من أن تبادر الدولة السورية والمجتمع المدني والقيادات الروحية والسياسية والمثقفين إلى بثِ روح وطنية واعية، تتسامى على الجراح، وتتجاوز الثنائيات المتجادلة والمتصادمة، وتذهب إلى مشاركة حقيقية في بناء الدولة وفق مشاريع عملية طموحة؛ و”المواطنة الشاملة” هي مفتاح رئيس لهذا التحول الذي ينشده السوريون وتتمناه لهم الدول والشعوب الصديقة.
النهار العربي
——————————-
سورية… فيدرالية الأمر الواقع!/ أحمد مولود الطيار
20 مارس 2025
يرى كثيرٌ من السوريين أنّ أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ”الجولاني”، هو “رجل المرحلة” والضمانة الوحيدة لعدم انزلاق سورية نحو المجهول، حتى إنّ بعضهم بات يردّد مقولةً مستعارة من النظام السابق مفادُها أنّه لا يوجد بديلٌ قادرٌ على إنقاذ البلاد.
غير أنّ هذا الطرح يواجه انتقاداتٍ جوهرية؛ إذ إنّ استمرار الشرع في السلطة قد يؤدّي إلى تفتيت سورية إلى دويلاتٍ وكياناتٍ طائفيةٍ وعرقيةٍ متجاورة، ممّا يجعلها عُرضةً لصراعاتٍ أهليةٍ متكرّرة قد تهدأ لفترةٍ ثم تشتعل مجدّدًا طالما بقي في موقع الحكم. يُضاف إلى ذلك أنّ الشرع نفسه، والجماعة التي كان يقودها (هيئة تحرير الشام)، يقفان حجر عثرةٍ أمام رفع العقوبات الأميركية المنصوص عليها في “قانون قيصر”.
منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر/ كانون الأوّل 2024، وتولّي أحمد الشرع رئاسة سورية، تمرّ البلاد بتحوّلات عميقة تعيد رسم خريطة النفوذ والسيطرة. ويبدو أنّ البلاد أصبحت مقسّمة فعليًّا بين قوى مختلفة، لكلٍّ منها تحالفاتها وحساباتها الخاصة، ممّا يثير تساؤلاتٍ حول ما إذا كان الشرع قد وافق ضمنيًّا على تقسيم سورية أم أنّه وجد نفسه مضطرًّا للتعامل مع واقع جديد مفروض عليه. ففي الجنوب، تبدو السويداء وكأنّها منطقة مستقلة بحكم الأمر الواقع، حيث لا يملك “الجيش العربي السوري” القدرة على دخولها أو فرض سيطرته عليها. يعود ذلك إلى عدّة عوامل، أبرزها التهديدات الإسرائيلية المباشرة، إذ أكّدت حكومة نتنياهو مرارًا أنّها لن تسمح بوجود أيّ قوةٍ عسكريةٍ تهدّد الدروز هناك. كما أنّ بعض القيادات الدرزية ومشايخ العقل لا يخفون وجود قنوات تواصل مع إسرائيل التي باتت تُعتبر بالنسبة لهم ضمانة لحماية مصالحهم وسط اضطرابات المشهد السوري. هذا التفاهم غير المعلن جعل السويداء عمليًّا خارج سيطرة دمشق، أشبه بمنطقةٍ ذات حكمٍ ذاتيٍّ غير رسمي.
في الشرق، وحيث تمتدّ منطقة الجزيرة السورية التي تشكّل 41% من مساحة سورية، فالوضع لا يقلّ تعقيدًا. فهذه المنطقة الغنيّة بالنفط والموارد الطبيعية بقيت خاضعةً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، رغم تغيّر القيادة في دمشق. وتشير المعطيات إلى أنّ الاتفاق بين الشرع و”قسد” أرسى نوعًا من التفاهم الهش، بحيث تحافظ الإدارة الذاتية الكردية على استقلاليتها مقابل تفاهماتٍ شكليةٍ تتعلّق بالسيادة مع الحكومة الجديدة. ولم تعد العلاقة بين واشنطن و”قسد” مجرّد تحالفٍ تكتيكي، حيث تستخدم الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية “عند الحاجة” كما يردّد البعض، بل تحوّلت إلى شراكةٍ استراتيجية، إذ ترى الولايات المتحدة في “قسد” شريكًا مهمًّا لضمان الاستقرار في المنطقة، بينما تعتمد القوات الكردية على الدعم الأميركي لتأمين استقلالية قرارها بعيدًا عن دمشق. في ظلّ هذا الوضع، لا يملك الشرع خيارًا سوى القبول بهذا الترتيب، ممّا يعني أنّ الجزيرة السورية أصبحت فعليًّا خارج السيطرة المركزية.
أمّا الساحل السوري، وإن بدا حاليًا ضمن النفوذ المركزي لدمشق، إلا أنّ مستقبله غير محسوم، خصوصًا بعد التطوّرات الأخيرة. فقد تآكلت شرعية النظام بين العلويين ولم تعد مضمونة، وهذا على افتراض أنّها كانت موجودة سابقًا، ما يفتح الباب أمام سيناريوهاتٍ مختلفة، من بينها تعزيز الحكم الذاتي أو البحث عن تحالفاتٍ جديدةٍ تضمن استقراره. وفي ظلّ هذا المشهد، يرى بعض المراقبين أنّ المناطق المتبقية تحت سيطرة الشرع باتت تشكّل ما يشبه “كانتونًا سنّيًّا”، حيث يسعى إلى موازنة علاقاته مع القوى الدولية والإقليمية لضمان بقائه. وهو يدرك أنّ الاعتراف الدولي بحكمه لن يتحقّق إلا إذا التزم بحدودٍ واضحة مع إسرائيل جنوبًا، وتجنّب أيّ مواجهة مع “قسد” شرقًا، وضمان مصالح تركيا شمالًا. وبهذا، تبدو حدود مناطق نفوذه مرسومةً بوضوح، من دون أن يكون قادرًا على توسيعها من دون الدخول في صدام مع القوى الفاعلة في الملف السوري.
وعلى الرغم من أنّ الشرع لا يصرّح علنًا بموافقته على تقسيم البلاد، فإنّ تحرّكاته وتفاهماته مع القوى الإقليمية والدولية تعكس قبوله ببقاء مناطق النفوذ الحالية طالما أنّها لا تهدّد سلطته في دمشق. فالسويداء تبقى خطًا أحمر بالنسبة لإسرائيل، والجزيرة محميّة أميركية بحكم الواقع، والشمال يخضع للتأثير التركي المباشر، بينما تحتفظ دمشق ومحيطها بسيطرة الشرع، مع تقديمه بعض التسهيلات الاقتصادية والسياسية لضمان اعترافٍ دولي ولو كان مشروطًا. وبذلك، يبدو أنّ أحمد الشرع قد اختار التعايش مع هذا الواقع بدلًا من خوض مواجهةٍ عسكرية مع القوى الكبرى والإقليمية التي ترسم حدود النفوذ في سورية. فالتقسيم غير المعلن بات أمرًا واقعًا، حيث تتقاسم البلاد قوى متعدّدة، فيما يحرص الشرع على تثبيت موقعه ضمن هذه الخريطة الجديدة، ولو كان ذلك على حساب وحدة سورية الكاملة.
وبعيدًا عن التدخّلات الدولية وصراع المصالح الإقليمية، يبقى الخطر الأكبر على وحدة سورية هو سياسات أحمد الشرع نفسه. فمنذ وصوله إلى السلطة، لم يقدّم مشروعًا وطنيًّا حقيقيًّا يهدف إلى إعادة توحيد البلاد، بل اعتمد على سياسة إدارة الأزمات عوضًا عن حلّها. وقد أدّى هذا الاستئثار بالحكم إلى عددٍ من المخاطر، أبرزها تعميق الانقسامات الطائفية والمناطقيّة، حيث بات لكلّ منطقة إدارتها الخاصة وعلاقاتها الخارجية المستقلة، ممّا يعزّز احتمالات التفتّت على المدى البعيد. بالإضافة إلى إقصاء القوى السياسية الأخرى، حيث لم يبادر الشرع إلى إشراك القوى الفاعلة في حوارٍ وطنيٍّ حقيقي، بل اكتفى بعقد تفاهماتٍ مع جهاتٍ خارجيةٍ للحفاظ على سلطته، ممّا أضعف إمكانية بناء دولةٍ مركزيةٍ متماسكة. كما استمرّ في ترسيخ حكم الفرد بدلًا من بناء مؤسساتٍ قويّة، ما يجعل البلاد أكثر هشاشةً أمام أيّ أزمةٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ مستقبلية.
في الوقت الحالي، يبدو أنّ السلطة في دمشق تعمل وفق معادلة “التكيّف مع الأمر الواقع” بدلًا من السعي إلى مشروعٍ وطنيٍّ يوحّد السوريين. ولكن يمكن للشرع تبنّي نهجٍ جديدٍ قائمٍ على حوارٍ وطنيٍّ شاملٍ وحقيقي يشمل جميع المكوّنات السورية، من الأكراد إلى الدروز إلى العرب السنّة والعلويين، إضافةً إلى إصلاحاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ حقيقيةٍ تعيد ثقة المواطنين بالدولة عوضًا من الرهانات على الدعم الخارجي. وذلك كفيلٌ بإطلاق إعادة إعمارٍ متوازنةٍ تشجّع اللاجئين والنازحين على العودة إلى مناطقهم، ممّا يعيد توزيع النفوذ الداخلي. ولكن نجاح هذا الحلّ يتطلّب إرادةً سياسيةً قوية، وهو ما لم يظهر حتى الآن لدى الأطراف المتحكّمة بالمشهد.
السيناريوهات القادمة التي تنتظر سورية كثيرةٌ ومفتوحةٌ على احتمالاتٍ شتّى، وأحد تلك السيناريوهات أن يبقى الوضع الحالي كما هو عليه من دون إعلانٍ رسميٍّ للتقسيم؛ حيث تحافظ دمشق على سيطرتها على بعض المناطق، بينما تستمرّ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد، ويبقى الشمال السوري خاضعًا للنفوذ التركي، والجنوب تحت تأثير إسرائيل بشكلٍ غير مباشر. وقد تحدث تحوّلاتٌ تدريجيةٌ، مثل توقيع اتفاقياتٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ بين مختلف الأطراف، ممّا يؤدّي إلى نوعٍ من “الكونفيدرالية غير الرسمية”. وفي ظلّ الوضع الحالي، قد يبدو هذا السيناريو الأكثر واقعيةً على المدى القريب؛ إذ لا تزال الأطراف المتصارعة غير قادرةٍ على فرض حلٍّ نهائي. أمّا على المدى البعيد، فقد تتّجه سورية نحو أحد السيناريوهين: الفيدرالية الموسّعة أو إعادة توحيد الدولة، وذلك بناءً على مدى قدرة القوى الداخلية على تجاوز الانقسامات، ومدى استعداد الدول الكبرى لدعم حلٍّ شامل. أمّا السيناريو الأسوأ فهو التفكّك الكامل، لكنّه يظلّ أقلّ احتمالًا حاليًّا، لأنّ معظم الأطراف الإقليمية والدولية ترفض تقسيم سورية رسميًّا.
العربي الجديد
————————
عِبر ودروس من أحداث الساحل السوري/ هنادي إسماعيل
21 مارس 2025
عاش السوريون أوقاتاً عصيبةً جدّاً، بعد انتشار أخبار ومقاطع مصوّرة تُظهِر تعرّض مدنيين علويين للقتل بأيدي مسلّحين من الطائفة السُّنية. وقع ما كان أهل الساحل يخشون حدوثه، وما كانوا يتحدّثون عنه عقوداً في خلواتهم، كمن ينتظر زلزالاً مُرتقَباً. أتذكّر صديقاً مقرّباً لوالدي، وهو مهندس سوري علوي، كان له منصب إداري حكومي مرموق في اللاذقية، وكان قد تخرّج من روسيا، مثل أغلبية الشبّان من جيله وطائفته، ممّن استفادوا من المنح الدراسية الحكومية إلى الاتحاد السوفييتي آنذاك، وكان معارضاً مسالماً مثقّفاً. وحين أقول معارضاً، أعني أنه كان ممتعضاً وغير راضٍ تماماً عن حكم العصابة الأسدية، بمعنى أنه لم يكن مُسيَّساً، بل تكنوقراطيّاً مثقّفاً. قرّر الرجل أن يهاجر إلى كندا مع أسرته الصغيرة، وأذكر، من حديث والدي الأخير معه قبل الهجرة، أن هاجس البقاء في سورية بالنسبة إليه كان مواجهة مستقبل مظلم، وقال لأبي حينها: سيأتي يوم ليس ببعيد يسقط فيه حافظ الأسد ويبدأ بعده حمّام دمٍ، يقتتل فيه السُّنة والعلويون في الساحل. كان هذا الحديث في أواخر ثمانينيّات القرن الماضي.
حفرت هذه العبارة في ذاكرتي الصغيرة، وكثيراً ما كنتُ أسمع الهواجس نفسها فيما بعد، سواء ضمن أوساط العائلة أو حين كان يجتمع أصدقاء أبي في بيتنا في اللاذقية، وهم من المثقّفين المسيحيين والسُّنة والعلويين والملحدين، من معارضين سابقين أو صامتين، ومنهم من يمكن اليوم أن يطلق عليهم من “الأغلبية الصامتة”. لا يخفى على أحد أن خلفية هذا الهاجس الساحلي، إن أردنا العودة إلى الوراء قليلاً، مجزرة حماة في عام 1982 على خلفية تمرّد مسلح قادته فرقة نُسبت إلى جماعة الإخوان المسلمين آنذاك. وقد قدّرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عدد الضحايا حينها بنحو أربعين ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، قتلوا ودفنوا جماعياً، ولم يتركوا وراءهم إلا بعض قصص الموت التي كانت تهمس في البيوت سرّاً وكثيراً من الخوف. هل كان صديق أبي الذي فرّ إلى كندا يخشى أن يدفع أطفاله يوماً ثمن ما اقترفته يدا حافظ الأسد وأخيه رفعت في حماة؟
اختار معظم أبناء الطائفة العلوية البقاء في سورية، في وقت كان فيه عدد لا بأس به من فئة التكنوقراط يسعى في حينها للهجرة إلى الخارج، فالامتيازات المتاحة لشباب الطائفة كانت بمثابة نقلةٍ نوعيةٍ في المستوى المعيشي قياساً بمعايير الظرف والمكان آنذاك. وجد كثيرون من شباب الطائفة فرصةً جيّدةً في الانتقال من مجتمع الزراعة والقرية إلى مجتمع المدينة، وأماناً مادّياً ثابتاً في وظائف الجيش والحكومة التي كانت متاحة لهم. ونتيجةً لذلك، ازدادت معدّلات الهجرة والتنقّل من القرى والمناطق الريفية إلى المدينة بشكل كبير، وتوسّعت المدن الساحلية لتُضمّ كثير من مناطق الطوق المتاخمة للمدينة ضمن توسّعات عمرانية سريعة، سكنها المهاجرون الجدد. وفيما بقيت كثير من هذه الأحياء الجديدة في اللاذقية ذات طابع اجتماعي متجانس، تقطنه أسر علوية من ذوي الدخل المحدود، توسّعت الأحياء الأقرب إلى وسط المدينة، وسكنها أقرباء عائلة الأسد، وكبار الضبّاط في الشرطة والجيش.
تميّزت المدن الساحلية من بقية المدن السورية بأنها نقطة تماسّ ساخن بين الطائفتَين عقوداً. والحقيقة أن هذا الشحن والتماس والاحتقان الاجتماعي لم يكن مبنيّاً على الانتماء الطائفي بقدر ما كان مرتبطاً بانتماء وولاء عصابات إجرامية محلّية للنظام، فكانت تمارس مختلف أشكال العنف والفوضى والإجرام، من اختطاف وسرقة وابتزاز وتهديد وفساد وتهريب ومحسوبيات، وترهب بقيّة السكّان في المدينة. وفيما ارتبطت قلّةٌ من الخارجين عن القانون من أبناء السُّنة بهذه العصابات، إلا أن معظم قادة هذه المجموعات وأفرادها كانوا من الطائفة العلوية، ومقرّهم بلدة القرداحة، مسقط رأس الأسد (الأب)، وكانوا يمارسون الإرهاب والإجرام باسم الطائفة والنظام. في الساحل، لم تكن الواسطة أو الرشى الطريقة الوحيدة لتسيير المعاملات الحكومية وخرق القانون، بل في كثير من الأحيان يكون مجرّد تأكيد الانتماء إلى الطائفة شفيعاً لشخص لقبه أو اسمه أو اسم عائلته لا يوحي بخلفيته الطائفية، ولطالما استجوبتُ في قاعة الامتحان في المدرسة والجامعة في محاولة لتقصّي خلفيتي الطائفية، وبالتالي فتح باب “المساعدة” والغشّ في الامتحان. ومع مرور عقود، أصبحت اللاذقية مركزاً للفساد وللخارجين عن القانون.
ولم تقتصر دائرة الفساد (فيما بعد) على فئةٍ أو طائفةٍ معينة، بل أصبح الفساد يمارَس أسلوبَ حياة وعمل وإدارة. وقد فرضت منظومة الإجرام والفساد المتأصّل في المجتمع تغييراً اجتماعياً كبيراً على جميع فئات المجتمع في المنطقة، فواقع الحال أصبح حالة اللاقانون والتجاوزات، ولم يعد أمراً يستنكره الناس أو يستغربونه، بل أصبحوا يستهزئون ويستهجنون من يخرج من هذه المنظومة. وبطبيعة الحال، وجدت غالبية أبناء الطائفة السُّنية من خرّيجي الجامعات أنفسهم من دون فرص عمل أو توظيف حكومي، فالتمييز الطائفي كان جزءاً من هذه المنظومة، ولم يجد أبناء السُّنة غير المقتدرين مالياً أملاً إلا الهجرة الاقتصادية، فكانت بلدان الخليج تستقبل معظمهم من الأطباء والمتعلّمين والأكاديميين. نحن إذاً أمام حالةٍ من تهجير أدمغة وإفقار فكري للبلاد، من ناحية، وحالة دمار للقيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع، من ناحية أخرى. يؤسّس الفساد المتأصّل وحالة التعايش مع الدمار الأخلاقي لانعدام الثقة بمصداقية الدولة والنظام الحكومي طبعاً، إلا أن الحال هذه في الوضع السوري، خصوصاً في الساحل، كانت تقودُه وتمارسه عصاباتٌ يقوم ولاؤها للنظام على أساس طائفي إجرامي. بعبارة أخرى، تستمدّ تلك العصابات الإجرامية المنظّمة شرعيتها ووجودها من انتمائها المذهبي وولائها الطائفي للنظام الحاكم.
ارتباط الفساد في سورية من أعلى رؤوس الهرم في النظام بهذه العصابات، عائلياً ومذهبياً، كان له أثر كبير في إحداث شرخٍ اجتماعي بين فئات المجتمع، من ناحية، وخصوصاً بين السُّنة والعلويين، وبين الأفراد عموماً، والدولة نظاماً وبنيةً، من ناحية أخرى. لقد آل الأمر في الساحل، وربّما في أغلب مناطق سورية، في العقود الثلاثة الأخيرة، إلى وضعٍ استباحت فيه جميع فئات المجتمع سرقة الكهرباء من الكابلات التي تزوّد الشوارع العامّة، والطرق، عبر تمديداتٍ كهربائيةٍ سرّيةٍ في بيوتهم. فالعلاقة بين الفرد والدولة هنا لم تكن تعاقديةً قائمةً على الحقوق والواجبات، بل كانت علاقة استيلاء واستغلال، يشعر الفرد ضمنها أن الدولة تسرقه بشكل أو بآخر، وأن الاستيلاء والكسب غير المشروعَين “شطارة” أو حقّ مشروع في أحسن الأحوال.
اكتسبت هذه المنظومة بعد اندلاع الثورة عام 2011 أبعاداً سياسية كيديّة في المجتمع، وأضيفت الوشاية والمكائد السياسية إلى قائمة الأدوات التي كانت تُستخدَم لتحقيق منافعَ ومكاسبَ مالية أو إدارية، وشهدت البلاد ظاهرة نهب وسرقات حكومية ضخمة. كذلك كان للعنف والاقتتال والمذابح التي ارتكبتها مليشيات طائفية (شيعية) عراقية وإيرانية ولبنانية، في الساحل وحمص خلال عقد ونيّف من الزمن، أثر كبير على تكريس التوتّر الطائفي بين الفئتَين، خصوصاً أن السواد الأعظم من الثوار والمعتقلين والضحايا كانوا من الطائفة السُّنية. بطبيعة الحال، لم تكن الثورة حِكراً على السُّنة، ولم يكن الدم الذي هُدر حِكراً عليهم أيضاً، إلا أن الحراك الشعبي غير المنظّم سياسياً، أي غير المؤدلج، كان من الطائفة السُّنية، وانضم إليهم أحرار الشعب من بقايا يساريين ووطنيين ومثقّفين وغيرهم، وكان بعضُهم من الطائفة العلوية، ومن المسيحيين، والأكراد، إلخ. ولا يتّسع السياق هنا لذكر المذابح التي اقتُرفت بحقّ المدنيين، سواء المتظاهرون السلميون منهم أو الآمنون في بيوتهم، وهي كثيرة ارتكبتها قوات النظام ومليشياته الطائفية، في اللاذقية ومناطق الساحل الأخرى.
لم يكن اشتعال الصراع اليوم في الساحل إذاً، كما يعلم كثير من أهل المنطقة، مفاجئاً. وفي الواقع، تاريخ العلاقة السياسية الاجتماعية بين الطائفة العلوية والدولة المركزية معقّد، ويعود تاريخه إلى فترة الحكم العثماني، ورغبة كثيرين من وجهاء العلويين ومشايخهم حينها في الاستقلالية السياسية ضمن نظام فيدرالي تحت حماية الانتداب الفرنسي، وهو ما أفضى حينها إلى تسمية الإقليم، الذي تولّت فرنسا حقّ انتدابه (بين عامي 1920 و1936)، رسمياً باسم “دولة العلويين”، أو “دولة جبل العلويين”، وليس “إقليم الساحل” مثلاً أو إقليم “اللاذقية وطرطوس”.
يستوجب هذا التاريخ المعقّد، بحيثياته العميقة التي فرضتها الأحداث الدامية خلال الأعوام السابقة، قراءةً شاملةً للمشهد اليوم، بعيداً من الحسابات السياسية وديناميكيات الصواب السياسي. ما نشهده اليوم من عنفٍ طائفيٍّ هو امتداد لتاريخ طويل من فقدان الثقة السياسية بين هاتين الطائفتَين، ومن سلسلة تاريخية من الاتهامات والتخوين والتشكيك. ينادي ناشطو الثورة اليوم في سياق تنديدهم بأحداث العنف في الساحل بوحدة الدم السوري، وحدة الشعب السوري، شعاراتٍ قامت عليها الثورة السورية منذ بداياتها في عام 2011، متغافلين عن السياق التاريخي للصراع والتوتّر بين الطائفتَين. بطبيعة الحال، لم تكن هذه الشعارات لترفع أيّام الثورة لو أن واقع الحال حينها كان لا يستدعي التذكير بهذه الروح الثورية النبيلة. بعبارة أخرى، رُفعت هذه الشعارات بوصفها محاولاتٍ نبيلةً لبتر الكره الطائفي، الذي كانت جذوره قد بدأت تعود إلى السطح مرّة أخرى حينها. ليس هناك أيّ شكّ لدى أيّ طرف في أن العنف الطائفي الإجرامي الذي حصل في الساحل كان مدفوعاً بالكره والغضب من الفئة، أو الفئات الشعبية، المسلّحة التي اقترفت هذه الجرائم بحقّ المدنيين بدم بارد. نقول هذا ونحن ما زلنا بانتظار نتائج تحقيق لجنة تقصّي الحقائق، ونقوله ونحن نعلم بأنه لولا تدخّل قوات الأمن لإيقاف العنف من جهة، وللتصدّي لعصابات الفلول الأسدية، من جهة أخرى، لكان حمّام الدمِ قد خرج من طوق الساحل حتماً. وعلينا، نحن الشعب أولاً، قبل الحكومة، مواجهة التاريخ والواقع، والاعتراف بهذا الماضي وقبوله، وهي عملية طويلة يتطلّب تحقيقها جهوداً سياسية تقودها لجان متخصّصة بالمساومة والصلح الأهلي. وهذه خطوة أساسية في مسار التعايش الأهلي وبناء الثقة بالدولة، وانخراط هذه الفئة الاجتماعية في الدولة المركزية مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات مع بقية فئات المجتمع.
ولعلّ هذه الجزئية تشكّل جانباً من تعقيدات المشهد السوري عامّة، فالقيادة الجديدة جاءت إلى الحكم بشكل مفاجئ، ويتّفق السوريون جميعهم بأن أحمد الشرع (والفصائل المسلّحة التي انضمت إليه في تحرير دمشق) غير معروف مسبقاً لهم، فكثير من السوريين لم يروا وجه قائد هيئة تحرير الشام قبلاً، ولم يتعرّفوا بوضوح إلى الفصائل الإسلامية الأخرى التي انضمت إلى هيئة تحرير الشام. وما زاد من غموض الوضع، صمت الرجل على الصعيد الداخلي خلال الأسابيع الأولى، وإحجامه عن مخاطبة الشعب، ووضع النقاط على الحروف في ما يتعلّق بمسائل مصيرية بالنسبة إلى الشعب السوري، مثل موضوع المحاسبة والمساءلة والعدالة الانتقالية، التي كانت (وما زالت) من أكثر النقاط المثيرة للحساسيات والنعرات الطائفية. وكانت بعض المصادر الإعلامية قد تداولت أنباءً عن مسامحات غير رسمية أجرتها الحكومة، وأخرى رسمية، في ظلّ صمت وإحجام رسمي عن التعليق على موضوع العدالة الانتقالية، كانت تقابلها تعليقات غير رسمية من الشرع حول أهمية المضي قدماً وتخطّي الخلافات.
لا يمكن للمراقب، في سياق فهم العنف الطائفي في الساحل اليوم، تجاهل أثر التغافل عن التطرّق إلى إشكالية المساءلة والعدالة بشكل واضح ومهني يحترم واقع الأمر والشعب، فالمطالبة اليوم بالمساءلة والتحقيق وتقصّي الحقائق، خلال مدّة أقصاها 30 يوماً، ليست إغفالاً لحقوق الملايين فحسب، وأغلبهم من الطائفة السُّنية، التي يُتوقّع منها اليوم المسامحة، بل هو قصورٌ في فهم ديناميكيات الصراع الأهلي وتأطيرها، خصوصاً في خطّ التماس في الساحل. معالجة إشكالية العدالة هي إحدى مقومات إرساء دولة المواطنة والعدل، ولبنة لا غنى عنها في مسار بناء الثقة بين الأفراد والدولة. كان على الرئيس أحمد الشرع التطرّق إلى هذا الموضوع الشائك في المراحل الأولى بعد التحرير، فالسرعة في تشكيل لجنة مستقلّة لتقصّي الحقائق لا يجب أن تكون خطوةً في مسار إثبات حسن النيات، بل إحدى الثوابت في مسار بناء السلم الأهلي.
أما الجزئية الأخرى من المشهد السوري المعقّد، فهي أحقية الشعب بالتحقّق من قيادته الحالية. ليس هناك شكّ، خصوصاً بعد حدوث العديد من الأخطاء الفردية أو تلك غير المحسوبة على الأمن العام، أن هاجس السيطرة الإسلامية على الواقع السياسي، حقيقي. وفي ظلّ غموض منهج القيادة الإسلامي في الحكم، يبقي وجود هذا الهاجس، وهذه المخاوف، عقبةً حقيقية في بناء الثقة بين الطوائف غير السّنية والمسيحيين، من جهة، والقيادة من جهة أخرى. فتاريخ المنطقة الحديث بعد “الربيع العربي”، وتصنيفات الولايات المتحدة والدول الغربية للجماعات الإسلامية المسلّحة، قد ساهما إلى حدّ كبير في شيطنة الإسلام السياسي. يأخذ هذا الأمر بعداً أكثر عمقاً في حالة الخصوصية السورية، والساحل تحديداً.
اندماج السوريين أبناء الطائفة العلوية في الدولة المركزية، التي تتّخذ طابعاً سُنّياً حتى الوقت الراهن، يبقى أمراً شائكاً. فحتى لو تحقّقت فرضية القضاء تماماً على بقايا الفلول المسلّح في المنطقة، تبقى إمكانية المشاركة السياسية غير واضحة الملامح، في ظلّ علاقة يشوبها الحذر، وإثبات حسن النيات والولاء، بدلاً من الثقة والمشاركة. وإثبات حسن النية لن يكون مقتصراً على العلاقة بين الطائفة العلوية والدولة، بل هي العلاقة بين الفئة السُّنية، التي حافظت على هويتها الثقافية، والطائفة العلوية، وهي علاقة لن تبنى إلا ضمن دولة العدالة والقانون والمشاركة السياسية. ونأمل أن تتمكّن الحكومة الانتقالية من اتخاذ خطوات مهنية وجادّة في مسار العدالة الانتقالية، خطوةً أولى في طريق تحرير سورية الفعلي من النظام البائد.
العربي الجديد
—————————
العنف الطائفي في سوريا.. تاريخ دموي حافل قبل أحداث الساحل محدث 21 مارس 2025/ محمد الريس
21 مارس 2025
رغم أنّها أعادت إلى الأذهان مشاهد من العنف الطائفي في سوريا، إلا أنّ أحداث الساحل لم تكن سوى قنبلة موقوتة تأجل انفجارها نحو ثلاثة أشهر بعد سقوط نظام الأسد، فما حدث خلال نحو 14 عامًا كان من المُستبعد أن ينتهي وتطوى صفحته بين ليلةٍ وضحاها.
ففي 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024 سقط نظام بشار الأسد، بعد معركةٍ خاضتها فصائل المعارضة المسلحة تحت اسم “ردع العدوان”، لتنهي عقب 11 يومًا من بدئها حكم حافظ وبشار الأسد الممتد منذ 53 عامًا، وتعلن انتصار الثورة بعد تعرّض الشعب السوري لأشنع طرق القتل وأعنفها على يد نظام الأسد منذ انطلاقته في مارس/ آذار عام 2011.
ولكن أين اختفت قوات نظام الأسد بعد سقوطه؟ سؤال كبير بقيت إجابته غير واضحة نحو ثلاثة أشهر، حيث كانت الوقائع تشير إلى أنهم بين قتيل وأسير وهارب خارج البلاد ومطارد داخلها، وأن معظم المطاردين خضعوا لعملية تسوية أطلقتها إدارة الأمن العام بعد سقوط النظام، وعليه فإن المتبقين منهم داخل البلاد ليسوا سوى مجرد فلول، بأعداد محدودة، متفرقين هنا وهناك.
هذا الاستنتاج نُسف بعد 6 مارس/ آذار عام 2025، حين أطلق عناصر موالون لنظام الأسد عملية عسكرية تسلَّلوا خلالها إلى مناطق عديدة ومراكز مدن رئيسة في الساحل السوري، حيث تم رصد انتشار أعداد كبيرة منهم تفوق 4 آلاف مسلّح في محافظتي طرطوس واللاذقية، لتصبح إجابة ذلك السؤال أكثر وضوحًا، وتنفجر تلك القنبلة الموقوتة بهذه العملية التي تبعها إعلان وزارة الدفاع السورية حملةً عسكريةً لبسط السيطرة على الساحل، تزامنًا مع دعوات أهلية وعشائرية للنفير العام من كل حدبٍ وصوب.
اندلعت المعارك، لكنّها أخذت سريعًا منحى طائفيًا، قد تتفاوت أسبابه المباشرة، بين احتضان الساحل لآلاف الخارجين عن القانون، أو استنفار القوى الأمنية، أو حالة الانفعال والحماسة الزائدة لدى البعض، لكنّها تعكس في مكانٍ ما حالة من التجييش لم تبدأ الآن، وإنما منذ عام 2011 مع ارتكاب الأسد مجازر طائفية قتلت آلاف الضحايا طعنًا وذبحًا وحرقًا ورميًا بالرصاص.
المجازر الطائفية في سوريا.. نهج الأسد لتثبيت حكمه
لم تبدأ الطائفية في سوريا مع أحداث الساحل، ولا بعد سقوط نظام الأسد، ولا عند انطلاق الثورة السورية عام 2011، بل سبقت ذلك بكثير، وتحديدًا بعد عام 1970، حين استولى حافظ الأسد على السلطة في سوريا، وأعطى أبناء الطائفة العلوية امتيازات واسعة، وبنى جيشًا وأجهزة أمنية على أساس طائفي، معززًا النفوذ العلوي وصولًا إلى السيطرة على مفاصل الدولة.
هذا النهج بدأه حافظ الأسد في السبعينيات، وحافظ عليه وريثه بشار من بعده، ليستخدمه على نطاق واسع بعد اندلاع الثورة السورية، وليربط زوال الطائفة العلوية بأكملها بزواله، ويخوّف أبناءها من الاحتجاجات الشعبية، ويوهمهم عبر وسائل إعلامه ومسؤوليه بأن هدفها إبادة العلويين، ليؤدي هذا الخطاب إلى ترسيخ الطائفية في النفوس والعقول، وليستخدمها بعد ذلك في تثبيت أركان حكمه.
وقد أدّى هذا الضخ الإعلامي وغيره من أنواع التجييش إلى ارتكاب 50 مجزرة طائفية على يد قوات نظام الأسد المدعومة بالميليشيات المحلية والأجنبية، التابعة لها، حيث استُخدمت فيها أشنع طرق القتل، من الذبح بالسكاكين إلى الطعن بحراب البنادق والسواطير، مرورًا بقطع الرؤوس، وليس انتهاءً بالإعدام الميداني بالرصاص، ثم حرق الضحايا بعد ذلك، لتقتل النيران من بقي في جسده بقايا روح، ولتشمل عمليات القتل الأطفال والنساء والمسنين، وليذهب ضحيتها نحو 3 آلاف مدني، تبعها عمليات حرق وتنكيل بالجثث، ورافقها عمليات اغتصاب للنساء، ونهب وسرقة وتخريب للمنازل، حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وكان لمدينة حمص النصيب الأكبر من المجازر، حيث ارتُكبت فيها 22 مجزرة، راح ضحيتها 1030 مدنيًّا، بينهم 209 أطفال و200 سيدة، تلتها محافظتا حلب وحماة بواقع 8 مجازر في كل منهما، إذ قُتل في حلب 411 مدنيًّا، بينهم 63 طفلًا و34 سيدة، بينما قُتل في حماة 197 مدنيًّا، بينهم 21 طفلًا و20 سيدة، فيما جاءت محافظة ريف دمشق بعدهم بـ5 مجازر، قُتل فيها 631 مدنيًّا، بينهم 120 طفلًا و113 سيدة.
أما محافظات طرطوس وإدلب ودرعا، فشهدت كلٌ منها مجزرتين، حيث قُتل في طرطوس 473 مدنيًّا، بينهم 98 طفلًا و75 سيدة، بينما قُتل في إدلب 35 مدنيًّا، بينهم 7 أطفال و8 سيدات، وقُتل في درعا 59 مدنيًّا، بينهم 6 أطفال و10 سيدات، فيما شهدت محافظة دير الزور مجزرة واحدة قُتل فيها 192 مدنيًّا.
رغم مسؤولية نظام الأسد عن النسبة الساحقة من المجازر الطائفية في سوريا، إلا أن أطراف النزاع الأخرى ارتكبت عددًا محدودًا من المجازر الطائفية والعرقية، ثلاثة منها على يد تنظيم الدولة، وأربعة اشترك بها طرف أو أكثر من فصائل المعارضة المسلحة، وثلاثة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية وحملت صبغة عرقية
وإذا جئنا إلى المجزرة الأكثر دموية، فكانت على أرض الساحل السوري، وتحديدًا في مدينة بانياس، حيث شهدت منطقتا البيضا ورأس النبع، في مايو/ أيار عام 2013، عمليات قتل بالرصاص وذبح بالسكاكين والسواطير وضرب بالحجارة لعوائل بأكملها، تبعها حرق وتقطيع وتشويه للجثث، حيث عثر الأهالي على أقدام أطفال صغار تم قطعها بالسكاكين، ليذهب ضحية ذلك 459 مدنيًّا، بينهم 92 طفلًا و71 امرأة، إضافةً إلى عشرات المفقودين والمخطوفين.
كما شهدت محافظة حمص أربع مجازر ضخمة من أصل 22 وقعت فيها، حيث قُتل في هذه المجازر الأربع ما يزيد عن 600 مدنيّ، أي أكثر من نصف عدد الضحايا الإجمالي البالغ 1030 مدنيًّا.
المجزرة الأولى وقعت في أحياء الرفاعي والعدوية وكرم الزيتون بمدينة حمص، في مارس/ آذار عام 2012، وقُتل فيها 224 شخصًا بينهم 44 طفلًا و48 سيدة، إضافةً إلى تسجيل عمليات اغتصاب للنساء، وحرق وتشويه للجثث.
وشهد حي دير بعلبة مجزرة كبيرة، في أبريل/ نيسان عام 2012، راح ضحيتها 200 مدني، بينهم 21 طفلًا و20 سيدة، ورافقها عمليات اغتصاب واسعة للنساء.
أما المجزرة الثالثة، فتعرضت لها قرى الحولة، في مايو/ أيار عام 2012، حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع الرجال والنساء، ثم ذبحهم بحراب البنادق والسكاكين، ثم رميهم بالرصاص، ليُقتل فيها 107 أشخاص، بينهم 49 طفلًا و32 سيدة.
كما شهدت قرية الحصوية مجزرة ضخمة، في يناير/ كانون الثاني عام 2013، قُتل فيها 108 مدنيين، بينهم 25 طفلًا و17 سيدة، منهم عائلات بأكملها، حيث ارتكبت عمليات القتل فيها رميًا بالرصاص وذبحًا بالحراب والسواطير، كما تبعها إحراق وتمثيل وتشويه للجثث، وكان من مشاهدها الصادمة أن عُلّقت بعض الجثث على أشجار في الطرقات وأسياخ تستخدم لذبح الحيوانات، كما عُثر على جثث مقطوعة الرأس، وجثة طفل مقلوعة العينين، وجثة رضيع داخل مدفأة، واغتُصبت سيدة أمام أطفالها.
أما أضخم مجزرة في محافظة حلب، فشهدتها قرية رسم النفل، في يونيو/ حزيران عام 2013، حيث نُفّذت فيها عشرات عمليات القتل الجماعي للنساء والأطفال والرجال والعجائز، ليبلغ مجموع القتلى نحو 192 مدنيًّا، بينهم 27 طفلًا و21 سيدة، فيما تعرّضت بلدة جديدة الفضل بمحافظة ريف دمشق في أبريل/ نيسان عام 2013، لعمليات إبادة جماعية طالت عوائل بأكملها، استُخدم فيها إلى جانب الرمي بالرصاص، طرق قتل بدائية كالرمي بالحجارة والذبح بالسكاكين، مما أدى إلى مقتل 191 شخصًا، بينهم 9 أطفال و8 سيدات، إضافة إلى عشرات المفقودين والمختفين قسريًّا.
هذا وشهد حيّا الجورة والقصور في مدينة دير الزور مجزرة، بين 27 سبتمبر/ أيلول و3 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012، قُتل فيها 192 مدنيًّا، بينهم 12 سيدة و7 أطفال.
هذه المجازر كانت جزءًا من 50 مجزرة ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها على أساس طائفي، فيما كانت الـ50 مجزرة جزءًا من منظومة القتل التي انتهجها نظام الأسد لسحق الانتفاضة الشعبية على مدار 14 عامًا، مستخدمًا أشنع طرق القتل وأعنفها، كالرصاص الحي، والبراميل المتفجرة، والأسلحة الكيماوية والحارقة، والقنابل العنقودية، والمسيّرات الانتحارية، وزرع الألغام، والتجويع، والاعتقال ثم الإخفاء القسري ثم القتل تحت التعذيب، والمفخخات وغير ذلك، لتترك هذه المأساة جراحًا عميقةً لم تلتئم حتى بعد سقوطه.
مجازر طائفية وعرقية أفرزتها الحرب
رغم مسؤولية نظام الأسد عن النسبة الساحقة من المجازر الطائفية في سوريا، إلا أن أطراف النزاع الأخرى ارتكبت عددًا محدودًا من المجازر الطائفية والعرقية، ثلاثة منها على يد تنظيم الدولة، وأربعة اشترك بها طرف أو أكثر من فصائل المعارضة المسلحة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة، وثلاثة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية وحملت صبغة عرقية، ليكون محصلة المجازر الطائفية والعرقية في سوريا 60 مجزرة، 50 منها على يد قوات نظام الأسد، و10 على يد جميع الأطراف الأخرى، وفقًا لتقرير الشبكة السورية الصادر في 14 يونيو/ حزيران 2015.
فقد قُتل 14 مدنيًّا رميًا بالرصاص في قرية حطلة ذات الغالبية الشيعية شرق مدينة دير الزور في 12 يونيو/ حزيران عام 2013، على يد فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة.
كما قُتل 10 مدنيين رميًا بالرصاص في بلدة صدد ذات الغالبية المسيحية جنوب محافظة حمص في 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2013، على يد فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة.
وقُتل 22 مدنيًّا في قرية مكسر حصان ذات الغالبية العلوية شرق محافظة حمص في 14 سبتمبر/ أيلول عام 2013، على يد جبهة النصرة.
كما قُتل 132 مدنيًّا في عدة قرى ذات غالبية علوية بريف محافظة اللاذقية في 4 أغسطس/ آب عام 2013، على يد فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة.
أما تنظيم الدولة، فمجازره الثلاث ارتكبها في عامي 2014-2015، وكانت في قرية التليلية ذات الخليط الإيزيدي السني بمحافظة الحسكة وقريتي المزيرعة والمبعوجة ذات الغالبية الإسماعيلية بمحافظة حماة، متسببةً جميعها بمقتل 58 شخصًا.
وفيما يخص المجازر الثلاث المرتكبة من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية على أساس عرقي، فقد وقعت خلال عامي 2013 و2014 في مناطق الأغيبش والحاجية وتل خليل وتل براك ذات الوجود العربي الكثيف بمحافظة الحسكة، وذلك بعد اقتحامها وتنفيذ عمليات إعدام بالرصاص الحي، حيث قُتل فيها جميعًا نحو 91 شخصًا.
أحداث الساحل.. ماذا حصل؟
مما لا شك فيه أن قوات الأمن السوري استطاعت حماية المواطنين المنتمين للطائفتين العلوية والشيعية في مدن حماة وحمص واللاذقية وطرطوس من عمليات قتل واسعة على أساس طائفي، وذلك منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024 حتى 5 مارس/ آذار عام 2025، أي نحو ثلاثة أشهر.
لكنَّ ما بعد 6 مارس/ آذار ليس كما قبله، حيث تعرّضت قوات الأمن السوري في اللاذقية وطرطوس لسلسلة من الهجمات والكمائن المتزامنة من قبل عناصر موالين لنظام الأسد، وقع إثرها عشرات القتلى والجرحى والأسرى الذين نُفّذت بحقهم إعدامات ميدانية فيما بعد، إضافةً إلى انتشار العناصر على امتداد مساحات واسعة في الساحل السوري.
هذا الحدث الأضخم من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، أعاد إلى أذهان السوريين زمن حكم الأسد، وسجن صيدنايا، والبراميل المتفجرة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والقتل تحت التعذيب، فخرج آلاف المتظاهرين في مختلف المدن السورية، مطالبين بالنفير العام والقضاء على الميليشيات الموالية للأسد والثأر لدماء ضحايا قوات الأمن العام.
وصارت حالة استنفارٍ عامةٍ تحركت معها الأرتال نحو الساحل السوري، قادمةً من عدة مدن وبلدات، واندلعت اشتباكات عنيفة ومعارك في عدة مناطق، خاضتها قوات الأمن رفقة فصائل عسكرية وجماعات مدنيّة مسلحة ضد فلول الأسد، مما عقّد مهمة ضبط تصرّفات جميع العناصر التابعة وغير التابعة للأمن العام، لتُرتكب خلال ذلك عمليات قتل على أساس طائفي وعمليات إعدام لأسرى من الفلول مجرّدين من سلاحهم.
كانت الحصيلة على خلفية هذه الأحداث، مقتل نحو 639 شخصًا، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
رغم وقوع عمليات قتل على أساس طائفي، إلا أن عمليات إعدام واسعة ارتُكبت على أساس المشاركة بالمعارك أو العثور على أسلحة داخل المنازل أو وجود محادثات وصور على الهواتف تُثبت تورّط أصحابها، وحينها لا تندرج التصفية ضمن التطهير الطائفي وإن كانت تُعد انتهاكًا للقانون.
ولعلَّ صعوبة الفصل بين الحالتين خلال التوثيق، تكمن في عدم ارتداء العناصر الموالين للأسد زيًّا عسكريًّا إذ يرتدون ملابس مدنيّة في حالات عديدة. كما رافقت أحداث الساحل حملة تضليل واسعة، شملت استخدام مقاطع قديمة، بعضها لمجازر نظام الأسد، وبعضها في بلدان أخرى، مع نعي عائلات وأشخاص كذّبوا لاحقًا خبر مقتلهم، حيث كشفت منصتا مسبار وتأكد عشرات الأخبار المُضللة، لكنهما في الوقت نفسه أثبتتا صحة عدة فيديوهات توثّق عمليات قتل في الساحل السوري.
ورجّح آخرون أن تكون بعض عمليات القتل المنسوبة للدولة السورية من صنيعة فلول نظام الأسد، لزرع الفتنة والانقسام في المجتمع السوري، خاصةً أن بعض ضحايا هذه العمليات كانوا من المعارضين السابقين لنظام الأسد، كما أن بعض الفلول يرتدون زي الأمن العام، مما يثير تساؤلات حول هدفهم من ذلك، يضاف إلى هذه القرائن أن قائد ميليشيا درع الساحل مقداد فتيحة سبق وأن هدد أبناء طائفته المعارضين لتصرفاته بـ”الحساب العسير”، مؤكدًا بأنه على دراية بأسمائهم وحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي وأماكن وجودهم وجميع المعلومات المتعلقة بهم.
لجميع ما سبق من تعقيدات وتعدد أطراف، كان من الضروري أن يكون هناك تثبّت وتحقق في كل حالة من حالات القتل والانتهاكات، لذلك أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ثم قررت تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، تبعهما إلقاء القبض على 6 عناصر ثبت ارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
ومنعت قوات الأمن السوري من تكرار أحداث الساحل في الأحياء ذات الغالبية العلوية بمدينة حمص، ومما ساعدها على ذلك قدرتها على التحرّك والسيطرة دون تعرضها إلى كمائن وهجمات كما حدث في الساحل، لتشكّل حائطًا بشريًّا في حي الحضارة وتحمي العلويين من أي هجمات انتقامية، خاصةً وأن محافظة حمص كانت صاحبة العدد الأكبر من المجازر الطائفية على يد نظام الأسد وميليشياته.
المصادر
خاص موقع التلفزيون العربي
———————————
هل تندلع الحرب بين أنقرة وتل أبيب على الساحة السورية؟!/ صالحة علام
20/3/2025
في تصعيد جديد ضد حكومة نتنياهو، صرّح الرئيس أردوغان بأن: “هناك قوى -لم يسمها- تحاول زعزعة الأمن والاستقرار داخل سوريا انطلاقا من إثارة النعرات الدينية والعرقية”، مؤكدا أن بلاده “لن تسمح بتقسيم المنطقة أو إعادة رسم حدوها بأطماع توسعية كما فعلوا قبل قرن من الزمان”، وأنهم سيجدون تركيا في مواجهتهم هذه المرة.
تصريحات أردوغان الجديدة جاءت ردا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة درعا، ومنطقة خان أرنبة في الجنوب السوري بالتزامن مع عودة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.
الموقف التركي من التحركات الإسرائيلية في المنطقة، التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية يبرز بقوة حجم المخاوف التركية من الأطماع التوسعية لدولة الاحتلال الصهيوني، والرغبة الجامحة لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق حلم نبوءة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
إذ سبق وأن حذر أردوغان من رغبة حكومة نتنياهو التي تقودها عقلية دينية متعصبة في التوسع جغرافيا على حساب الخريطة التاريخية لبلاده، والاستيلاء على مناطق الأناضول، تحقيقا لوهم الأرض الموعودة، والعمل على إقامة كيانات تابعة لها في كل من شمال العراق وسوريا عبر استغلال علاقاتها بالتنظيمات الانفصالية، في إشارة لعدد من الأقليات السورية الطامحة في الحكم الذاتي، ولقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لديها علاقات ممتدة بتل أبيب.
وكانت العديد من التقارير المتداولة إعلاميا قد أفادت أن توقيع قادة قوات سوريا الديمقراطية على اتفاق الاندماج داخل الإدارة الجديدة مع دمشق لم يقف حائلا دون استمرارهم في السعي لتأمين دعم إسرائيلي لهم في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة لهم، التي يحتاجون فيها -وفق رؤيتهم للتطورات بالمنطقة- لتوفير حلفاء وضامنين جدد لديهم القدرة على حمايتهم والوقوف إلى جوارهم.
وهو ما وافق هوى إسرائيل التي لا تنظر بارتياح لهذا الاتفاق، وترى أن تراجع الأكراد للخلف سيفسح المجال أمام عودة (داعش)، مما يضعها في موقف دفاعي صعب، إلى جانب شكوكها القوية وعدم ثقتها في الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي تمتد جذور انتماءاته إلى تنظيم القاعدة والجماعات الإسلامية الجهادية، مما قد يعرض أمنها للخطر، ويهدد وجودها.
ترى إسرائيل أيضا أن الجيش السوري الجديد الذي أُعيد بناء عناصره وتدريبهم بإشراف كامل من قيادات القوات المسلحة التركية، وتم تزويده بترسانة من الأسلحة المحلية المنتجة داخل هيئة الصناعات الدفاعية التركية أصبح يمثل خطرا من نوع آخر عليها، في ظل اتساع حجم النفوذ التركي داخل سوريا.
الذي يأتي متزامنا مع زيادة حدة التوترات وتفاقم خلافاتها مع أنقرة، على خلفية حربها ضد كل من قطاع غزة ولبنان، واختلاف أجندة كل منهما فيما يخص مستقبل الدولة السورية، إذ تعتقد إسرائيل أن تقسيم سوريا، وخلق كيانات متعددة بها من شأنه أن يضمن لها أمنها، ويمنحها الفرصة كاملة لتحقيق رغبتها في توسيع مساحتها.
ومن هذا المنطلق تدعم مطالب الحكم الذاتي لكل من الأكراد، والدروز، والعلويين، وتبذل جهودا مضاعفة حاليا من أجل دعم الطائفة الدرزية، حيث تم مؤخرا إرسال 10 آلاف طرد من المساعدات الإنسانية لأفرادها، وصرح جدعون ساعر وزير خارجية الكيان الإسرائيلي أن علاقاتهم بالدروز تاريخية، وأن عليهم الوقوف إلى جانبهم، لأنه “في منطقة نكون فيها أقلية، فمن الصواب دعم الأقليات الأخرى”.
أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس فصرّح أن حكومته قررت السماح للدروز من الجانب الآخر من الخط الفاصل بدخول هضبة الجولان والعمل بها، معربا عن استعدادهم للدفاع عنهم والوقوف إلى جوارهم دائما، بينما أعلن مسؤولون إسرائيليون أنهم لن يقبلوا وجود أي عسكري سوري في المناطق الجنوبية للعاصمة دمشق، وأنهم على أتم استعداد لغزو ضواحيها دفاعا عن الأقلية الدرزية المنقسمة بين إسرائيل وسوريا.
إلى جانب التصدي لمحاولات تركيا وأردوغان الرامية إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، واستعادة سيطرة بلاده على خريطة المنطقة كما كان عليه الحال في عهد الدولة العثمانية، وفي تقديم نفسها الوجود كقوة إقليمية فاعلة ذات نفوذ، لديها القدرة على التحكم في مستقبل المنطقة وفرض سيطرتها على مقدرات شعوبها، وهو ما يطلق عليه نتنياهو اسم “الشرق الأوسط الجديد”.
التحركات الإسرائيلية الداعمة للمطالب الانفصالية للأقليات السورية، والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد الأراضي السورية تنظر إليها أنقرة بريبة وشك، وتضعها في موقف الاستعداد لمواجهة تطورات الأمر بالسبل الممكنة كافة، حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية المباشرة.
لما تمثله هذه التحركات من تهديد مباشر لأمنها القومي، ومحاولة من جانب الكيان المحتل لتقويض مكانتها الإقليمية، وزعزعة استقرارها، والنيل من وحدة أراضيها عبر تشجيع الدعوات الانفصالية، ومساندة ودعم العناصر المسلحة التي تنتمي للتنظيمات الإرهابية لتخريب السلم الاجتماعي بالمنطقة.
وخلافا للرؤية الإسرائيلية التي تشجع على تقسيم سوريا وتعمل عليها، ترى تركيا أن وحدة الأراضي السورية، وإقامة دولة مركزية قوية ومستقرة بها من شأنه ضمان إخراج التنظيمات الانفصالية المسلحة، وإبعادهم تماما عن مناطق تمركزهم، والتخلص من تهديداتهم، بما يفسح المجال أمام الحفاظ على استقرار المنطقة، وإشاعة السلام بين شعوبها وتحقيق أمن دولها القومي.
ولتحقيق هذه الأهداف مجتمعة سعت أنقرة إلى زيادة حجم تعاونها العسكري مع دمشق عبر الاستعداد للتوقيع على اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، كما تم تعيين ملحق عسكري في السفارة التركية بدمشق، بينما قام مؤخرا وفد يضم كلًا من وزيري الخارجية والدفاع، ورئيس الاستخبارات بلقاء المسؤولين السوريين في دمشق، حيث تم تأكيد تمسك أنقرة بتسليم العناصر المسلحة لأسلحتها، وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، إلى جانب التباحث حول العديد من القضايا الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، التي من بينها بحث إقامة قاعدتين عسكريتين لتركيا في كل من دمشق وحمص، واستمرار عمليات تدريب الجيش السوري وتسليحه.
وهي التحركات العسكرية التي تراها إسرائيل تمثل تهديدا لها سواء على صعيد الجيش السوري الذي قد يصبح وكيلا لتركيا في حرب مباشرة ضدها، أو على صعيد تركيا نفسها التي يتزايد وجودها العسكري على الأراضي السورية، ودعمها المطلق لحكومة الشرع المؤقتة، وتزايد تهديداتها والتصعيد المستمر في خطابها العدائي ضد إسرائيل سواء من الرئيس أردوغان أو كل من وزيري خارجيته ودفاعه.
ما يبدو أنه شجع الشرع على التخلي عن أسلوبه الذي اتسم باللين تجاه إسرائيل منذ وصوله إلى دمشق، ليستخدم أسلوبا أشد حدة في الخطاب الذي ألقاه مؤخرا في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بالقاهرة، حينما قال: “إن توسع العدوان الإسرائيلي ليس انتهاكا للسيادة السورية فحسب، بل هو تهديد مباشر للأمن والسلام في المنطقة بأسرها”.
تعزيز تركيا لقدراتها العسكرية وتطوير دفاعاتها الهجومية وصواريخها الباليستية، وتعاونها المطلق مع سوريا في المجال العسكري تحديدا، وتصعيد تصريحات مسؤوليها ضد تل أبيب ينبئ بأن هناك استعدادات تجري انتظارا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة التي قد تشهد اشتباكا مسلحا بينها وبين إسرائيل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق غير مباشر.
المصدر : الجزبرة مباشر
كاتبة وصحفية مصرية مقيمة في تركيا
حاصلة على الماجستير في الاقتصاد.عملت مراسلة للعديد من الصحف والإذاعات والفضائيات العربية من تركيا
———————————
حتى لا يتكرّر السيناريو العراقي في سورية/ محمد أحمد بنّيس
20 مارس 2025
يُلقي السيناريو العراقي بظلاله على المشهد السوري بعد أعمال العنف الطائفية التي عرفها الساحل. وعلى الرغم مما أبداه غالبية السوريين من وعيٍ بضرورة تخطّي المخلّفات الاجتماعية والنفسية لما حدث، والانحياز لخيار الوحدة الوطنية، والحدّ من التوتّر الناجم عن الانقسام الفكري والطائفي… على الرغم من ذلك، لا يبدو ما حدث في العراق، من احترابٍ طائفيٍّ دامٍ بين 2006 و2008، بعيداً من التحقّق في الساحة السورية، خصوصاً أن من شأن ما يشهده الإقليم، من متغيّراتٍ نتيجة التداعيات المستمرّة لحرب غزّة، أن يدفع المشهد السوري إلى مزيدٍ من التأزّم.
كان الاحتراب الطائفي الذي شهده العراق، بعد الاحتلال الأميركي وسقوط نظام صدّام حسين، أحدَ أكثر الفصول دمويةً في تاريخه منذ تأسيس الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الأولى، فقد أودى بحياة عشرات آلافٍ من المدنيين الذين سقطوا في أعمال عنفٍ وقتل جماعيٍّ وهجمات، استهدفتهم في مناطق ذات أغلبية سُنّية أو شيعيّة في بغداد وغيرها. وللتاريخ، كان لسياسات النخبة العراقية الجديدة، وتحديداً حكومة نوري المالكي الأولى، أثرُها في إذكاء نار الفتنة المذهبية بين العراقيين، والتأسيس للطائفية السياسية، في ضربٍ سافرٍ لأسس الدولة المدنية والديمقراطية القائمة على المواطنة والتعدّدية والتعايش. واليوم، لا تبدو الحكومة السورية الجديدة معنيةً بالانخراط في تدابيرَ جادّةٍ من شأنها أن تحول دون انجرار سورية إلى السيناريو العراقي؛ فقد أخفقت في إعادة بناء المؤسّستين، الأمنية والعسكرية، بشكلٍ يقطع مع مظاهر التسلّح غير النظامي، ويساعد في احتكار العنف الشرعي بما يضمن الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. كما أن الإعلان الدستوري، الذي يُفترَض أن يضع خريطة طريق واضحة للتحوّل نحو الديمقراطية، عكس، في النهاية، حسابات هذه الحكومة، أو بالأحرى حسابات تشكيلاتها العسكرية، وتطلّعها إلى إقامة نظامٍ سلطويٍّ لا يخلو من طائفية بادية.
ليس من السياسة والحكمة في شيءٍ تحميل الطائفة العلوية جرائم النظام السابق، والتوسّل بخطابٍ سُنّيٍّ (أمويٍّ) يستضعفها في استئساد طائفي رخيص. ما جرى في مدن الساحل وبلداته من فظائع بيد تنظيماتٍ مسلّحةٍ غير نظامية، لا يستدعي مسؤولية النظام الجديد في حفظ النظام العام فقط، بقدر ما يسائل كذلك شرعيتَه السياسية، وقدرتَه على تأمين المسار الانتقالي، الذي يُفترَض أن ينتهي بإقامة دولةٍ مدنيةٍ وديمقراطيةٍ تسع السوريين كلّهم، بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية والدينية والعرقية.
أخفق هذا النظام في أول اختبار سياسي وأخلاقي بعد سقوط نظام الأسد، فمن جهة، لم يحُل دون استدراج بعض جماعاته العسكرية (الجهادية) إلى ارتكاب مجازر مروّعة، كان بوسعه تجنّبها لو توفّق في إدارة تدخّله ضدّ فلول نظام الأسد بأقلّ الخسائر. ومن جهة أخرى، عجز عن حماية مئات المدنيين من الطائفة العلوية الذين سقطوا ضحية إرهاب هذه الجماعات. وعوض أن يعمل على اجتثاث الطائفية السياسية، التي زرعها حكم الأسد، سعى إلى تكرار السيناريو العراقي، عن قصدٍ أو من دون قصد، بإعادة إنتاج نسخةٍ أخرى منها أكثر ضحالةً، تتغذّى على الانتقام والثأر وفتح جردات الحساب الطائفية.
تستوجب الانتهاكات الفظيعة، التي راح ضحيتها مئات المدنيين (سُنّةً وعلويين) في الساحل السوري، محاسبةَ الجناة المسؤولين عنها. وأي تأخّرٍ في ذلك ستكون له تبعات على السلمين، الأهلي والاجتماعي. ويبقى أخطرَ ما يتهدّد المشهدَ السوريَّ دخولُ دولة الاحتلال على الخطّ، وسعيُها إلى تغذية الاحتقان الطائفي الذي سبّبته أحداث الساحل. واستقبال رجال دين سوريين دروز في الأراضي الفلسطينية المحتلّة يطرح أكثر من تساؤلٍ حول استراتيجيّتها (إسرائيل) لضرب الوحدة الوطنية السورية، بذريعة حماية الأقلّيات، هذا من دون إغفال ما يمكن أن يُسفر عنه الخطاب المتنامي في كواليس المنظمات الدولية بشأن حقوق هذه الأقلّيات ومستقبلها.
يُؤمل أن يكون السوريون قد استوعبوا دروس أحداث الساحل على ما فيها من مآسٍ، ذلك أن تكرارها واتساع رقعتها وتساهل النظام الجديد مع المسؤولين عنها… ذلك كلّه يفتح الباب على مصراعيْه أمام خطر ضرب مقوّمات النسيجين، الوطني والأهلي، السوريين.
العربي الجديد
—————————
حين يكرّر التاريخ أحداثه/ رشا عمران
21 مارس 2025
أُنقِذ شخصان عند سواحل قبرص بعد غرق زورق صغير يحمل أكثر من 27 شخصاً، قادماً من مدينة طرطوس السورية، من دون أيّ معلوماتٍ عن مصير باقي المفقودين.. بدأت التغريبة السورية الجديدة، قتل وحرق وخوف وتهجير. سوريون يُقتَلون مجدّداً محمّلين بذنوبٍ لم يرتكبوها، سوريون يُهجَّرون من بيوتهم بعد نهبها وحرقها، ويُترَكون لمصائرهم في البراري والغابات، يتعرّض أولادهم لعنف البرّية، الذي بات أكثر رأفة بالبشر من أبناء جلدتهم. سوريون محاصرون من قوات “جيش وطني” يمنع عنهم الطعام والدواء وحليب الأطفال، بعد منع وسائل الإعلام الأجنبية من الدخول إلى هذه المناطق وتغطية ما يحدث من فظائع.
الذريعة القديمة جاهزة، هي ذاتها لم تتغيّر: مسلحون يريدون تقويض دعائم الدولة يختبئون بين المدنيين، وعليه فيجب الفتك بالمدنيين عقاباً لهم على انتماء المسلحين إليهم. تُستبدل مفردة الإرهابيين السابقة بمفردة الفلول، من دون أن يتغيّر المسار الذي كان سائداً في سورية منذ عام 2011، هناك تبادل للأدوار فقط.
في السابق، قبل سقوط نظام الأسد، كان شبّيحة نظام الأسد يوجّهون تهمة دعم الإرهاب لكلّ متعاطفٍ مع الثورة أو مع الضحايا من المدنيين والأطفال. اعتقل النظام السابق مئات الآلاف بذريعة تمويل الإرهاب، كان هذا التمويل لإغاثة المناطق المنكوبة والمحاصرة من جيش النظام والفصائل المسلّحة التابعة له. اليوم أيضاً، تُطلَق تهمة الفلول أو دعم الفلول على كلّ من يناصر ضحايا الساحل أو يحتجّ على الممارسات الطائفية التي يرتكبها “الجيش الوطني”، أو عناصر من “الأمن العام”، بحقّ المواطنين السوريين. ثمّة شبيحة واقعاً وافتراضاً لكلّ نظام يرتكب المجازر وينتهك حرّية المواطنين وكراماتهم، ويعمل على إذلالهم. ثمّة شبيحة سوريون دائماً ينتهكون حرمة إخوتهم السوريين. هو تبادل للأدوار فقط، يمنع عن السوريين جميعاً حقّهم في العيش الكريم في وطنهم الوحيد.
ثمّة مظلومياتٌ جديدة تحدث أيضاً. مظلوميات مثقلة بإرث دموي وبذاكرة دموية وبضمائر ميّتة. هذه المظلوميات التي تتناقلها أجيال من السوريين تجعل من الضحية السابقة مجرماً لاحقاً، أو أقلّه، مؤيداً للإجرام ومبرّراً له وساعياً إلى خلق الأعذار لسفك الدماء، وثمّة مجرمون دائماً يشتغلون على إبقاء هذه المظلوميات قيد التداول، كما لو أنها مرويات تُتناقل من جيل إلى جيل… بالطبع، فسردية المظلومية الدموية وحدها هي الكفيلة بإبقاء الحقد يتنقل من مكان إلى آخر، ويحمل ما يمكنه من الحكايات التي تقتات عليها فترات السكون. هل راقبتم جحافل النمل تنتقل من مكان إلى آخر وهي تحمل ما تقتات عليه في أوكارها الصغيرة في فترات السكون؟ هذا تماماً ما تفعله سردية الحقد، وهي تراكم التفاصيل، ثمّ يأتي من يستهلكها لخراب المجتمعات والأوطان، مهيئاً المساحة لحكايات جديدة تستند إلى مظلومية جديدة تراكم حقداً جديداً… وهكذا.
عادةً ما تملك الأنظمة الاستبدادية براغماتيةً تمكّنها من الظهور بمظهر حامي المجتمع، من تأجيج تلك المظلوميات وحقن مخرجات سرديات الحقد. اشتغل نظام الأسد في مرحلتي الأب والابن (قبل 2011) على هذا النوع من البراغماتية، ساعده في ذلك أن الطبقة الأوليغارشية المحيطة به كانت مؤلّفةً من “المكونات” السورية كلّها. لكن في الوقت ذاته كانت طوابيره التحتية تعمل في حقن المجتمع بالمرويات عن مظلوميات تعزّز حقداً دفيناً لا يمكن التخلّص منه بسهولة، ظهر واضحاً ما أن بدأت ثورة السوريين في عام 2011، حينها أيضاً تخلّى نظام الأسد الابن عن طوابيره السرّية، وبات علنياً في تكريس الحقد، لكنّه أيضاً احتفظ بمساحة تحميه من التهمة حين أحاط منظومة إجرامه ببطانة من “المكونات” كلّها. كان يمكن لمن جلس في مكان نظام الأسد (بعد هروبه) أن يفضح ما حدث، وأن يقدّم الحقائق كما حدثت، لولا أن منظومته الفكرية ذاتها مبنية على مظلومية دموية طائفية يعود تاريخها إلى ما قبل الألف عام، وتغذّت بقوة بعد ثورة السوريين 2011. كان يمكنه إنقاذ سورية ومجتمعها من هذا الخراب، لولا أنه يدرك أن بقاءه يستند إلى تعزيز هذه المظلومية لدى فئات كبيرة من ضحايا الأسد، وأن عليه أن يقدّم لهم قربانا ليعلنوه بطلاً. هكذا يعيد التاريخ السوري نفسه من دون أن يدرك الشعب أنه وحده الضحية.
العربي الجديد
———————————
سوريا: ما علاقة تمرد الساحل السوري بإسرائيل؟
المدن – عرب وعالم
الأربعاء 2025/03/19
كشف تحقيق استقصائي لمنصة “إيكاد” أسراراً جديدة عن “لواء درع الساحل” الذي قاد التمرد ضد الحكومة السورية في الساحل السوري، حيث ظهر وجود ارتباط بدوائر إعلامية إسرائيلية.
“لواء درع الساحل”
وقال التحقيق إن “اللواء” تأسس في شباط/فبراير الماضي، على يد جندي سابق في جيش النظام المخلوع، يدعى مقداد فتيحة من مدينة جبلة في ريف اللاذقية، وكان مقاتلاً في صفوف “الحرس الجمهوري”.
وأضاف أن فتيحة عمل ضمن صفوف “الفرقة-25” التي كان يقودها العميد سهيل الحسن (النمر)، موضحةً أن فتيحة لديه سجل حافل بالجرائم والانتهاكات والتمثيل بالجثث والقتل خارج القانون، خلال سنوات الحرب السورية.
وأوضح أن إحدى الصور أظهرت فتيحة وهو يجلس بجانب جثة قد قام بحرقها، وكان يدخن سيجارة وينظر إلى الكاميرا متباهياً في عمله الشنيع، حيث علّق أحد الأشخاص على الصورة بأنها “الأخذ بالثأر لروح فادي زيدان من قرية متور بريف جبلة” وهو أحد المقاتلين الذين قتلوا سابقاً.
وظهرت له صور عدة وهو يحمل رؤوس قد قام بقطعها من أجساد أصحابها، وأخرى أثناء قيامه بتعذيب أحد الثوار، كما ظهر له فيديو وهو يقوم بتصوير عدداً من الجثث المرمية على الأرض بعد قتلها وإعدام أصحابها.
بعد سقوط النظام السوري، قام فتيحة بنشر مقاطع فيديو، يهدد فيها الأمن العام وينشر الفتنة ويبث النعرات الطائفية، وتبنّى عدة هجمات على حواجز للأمن العام في الساحل السوري.
ارتباط بإسرائيل
ومن خلال تتبع فريق “إيكاد” لمنصات “لواء درع الساحل”، على مدى أيام من تمرد الساحل السوري، كشف عن أسرار جديدة، منها ارتباطها بصفحات إسرائيلية، وعمليات تضخيم إعلامي مدروسة، وشخصيات وألوية منضوية تحتها يرجّح أنها وهمية وتحاول هذه الحسابات تصديرها.
وفي 6 آذار/مارس الحالي، بالتزامن مع بدء التمرد، نشرت صفحة تحمل اسم “مقداد فتيحة- لواء درع الساحل الاحتياطي”، مقطعاً مصوراً لفتيحة يعلن فيه عن التمرد المسلح ضد الحكومة السورية. وبعد لحظات فقط من نشره، بدأت صفحات تابعة للنظام المخلوع، بالترويج لمحتوى مشابه، ما يشير إلى احتمال وجود تنسيق إعلامي مدروس.
احداث الساحل
وشهد الساحل السوري من 6 و10 آذار/مارس، أحداث تمرد ضد الحكومة السورية، قادها فتيحة والقيادي البارز في الفرقة الرابعة سابقاً، غياث دلة، بدأت بمهاجمة حواجز للأمن العام السوري، والسيطرة على بعض المواقع في جبلة وبانياس.
واستطاع الجيش السوري السيطرة على التمرد وبسط نفوذه مجدداً على مناطق التمرد، بعد اشتباكات عنيفة شاركت فيها فصائل معارضة محسوبة على الوزارة إلى جانب مجموعات شعبية، ارتكبت خلالها انتهاكات بحق المدنيين من الطائفة العلوية.
ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص جراء التمرد الذي قاده فتيحة ودلة وضباط آخرين من نظام بشار الأسد المخلوع، ضمنهم 172 عنصراً من قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، و211 مدنياً، قُتلوا على يد المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد، بينما لقي 420 شخصاً مصرعهم، على يد القوى المحسوبة على وزارة الدفاع.
——————————————-
هل ما زالت لـ”حزب الله” مراكز داخل سوريا؟/ سوسن مهنا
التوترات بين “حزب الله” والجيش السوري ليست مجرد حادثة عابرة أو صراع محلي، بل تعكس تغيراً في المعادلات الإقليمية وتطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للحزب، وما إذا كان يسعى إلى إعادة رسم دوره في الداخل السوري، أو الدفاع عن مصالح استراتيجية متعلقة بتهريب السلاح والمخدرات، أو حتى إيصال رسائل سياسية إلى دمشق وحتى طهران.
خلال الأيام الأخيرة شهدت الحدود اللبنانية – السورية تصعيداً ملحوظاً بين “حزب الله” ووحدات من وزارة الدفاع السورية على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية مسلحين من “حزب الله” بعبور الحدود إلى الأراضي السورية في ريف حمص وقتل ثلاثة من أفراد الجيش السوري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع أن مجموعة من “ميليشيات حزب الله” قامت عبر كمين بخطف ثلاثة من عناصر الجيش السوري عند الحدود اللبنانية قبل أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم بـ”تصفيتهم”، وأضافت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد هذا “التصعيد الخطر من قبل ميليشيات حزب الله”، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب سد زيتا غرب حمص.
في المقابل نفى “حزب الله” خلال بيان بصورة قاطعة ما يجري تداوله حول وجود أي علاقة له بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية – السورية، وأضاف “نجدد تأكيد ما سبق وأعلناه مراراً، أن لا علاقة لـ’حزب الله‘ بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية”.
ورداً على مقتل الجنود قامت القوات السورية بقصف بلدات لبنانية حدودية، مما أدى إلى نزوح سكان بلدة القصر اللبنانية.
ورد الجيش اللبناني بدوره على مصادر النيران من الأراضي السورية وأرسل تعزيزات إلى المنطقة الحدودية لضبط الأمن، وكانت قوات “الفرقة 52” في وزارة الدفاع السورية حشدت على المنطقة الحدودية واشتبكت مع عناصر لـ “حزب الله”، مما أدى إلى طرد مسلحي الحزب من قرية حوش السيد علي السورية والسيطرة عليها وعمدت إلى تمشيط المنطقة المحيطة التي كانت تعتبر تجمعاً لعناصر الحزب وفلول نظام بشار الأسد.
وأوضح مصدر من وزارة الدفاع السورية لوكالة “سانا” أن قوات الجيش تستهدف تجمعات وتحركات “حزب الله” في المنطقة، بخاصة في قرية حوش السيد علي السورية “التي أصبحت وكراً لميليشيات حزب الله في أيام النظام البائد”، مضيفاً “نهدف من تحركاتنا على الحدود إلى طرد ميليشيات حزب الله من القرى والمناطق السورية التي تتخذها كأماكن موقتة لعمليات التهريب وتجارة المخدرات”.
وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه أنه ضمن مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية “المطلبة في منطقة القصر- الهرمل والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع – بعلبك”.
وفي حديث للباحث في مؤسسة “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين قال إن بلدة حوش السيد علي هي بلدة لبنانية تبعد من العاصمة بيروت 160 كيلومتراً في قضاء الهرمل (البقاع)، “وعندما رُسمت الحدود بين سوريا ولبنان قبل نحو قرن من الزمن قسمت البلدة إلى جزءين، القسم الأول والأكبر يبلغ نحو أربعة ملايين متر مربع ويقع في الأراضي اللبنانية والقسم الثاني الذي تبلغ مساحته نحو مليون متر مربع يقع في الداخل السوري، وسكان القسمين هم من اللبنانيين وهم امتداد لعائلات واحدة”.
117 موقعاً حيوياً لـ”حزب الله” في سوريا
هذه التوترات بين “حزب الله” والجيش السوري ليست مجرد حادثة عابرة أو صراع محلي، بل تعكس تغيراً في المعادلات الإقليمية وتطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للحزب، وما إذا كان يسعى إلى إعادة رسم دوره في الداخل السوري، أو الدفاع عن مصالح استراتيجية متعلقة بتهريب السلاح والمخدرات، أو حتى إيصال رسائل سياسية إلى دمشق وحتى طهران.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل لا يزال “حزب الله” يحتفظ بمواقع له داخل الأراضي السورية؟
منذ تدخله في الصراع السوري عام 2011 عزز الحزب وجوده العسكري في محافظات سورية عدة، بما في ذلك دمشق وريفها وحلب وحمص ودير الزور ودرعا والسويداء وإدلب وحماة، ويقدر أن الحزب كان يسيطر على أكثر من 117 موقعاً حيوياً في سوريا، تتنوع بين مقار عسكرية ونقاط حراسة ومستودعات أسلحة.
وتعرض دراسة صادرة عن مركز “جسور” للدراسات في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 انتشار “حزب الله” في سوريا والمواقع التي تمركز بها، ووفقاً للدراسة أن ذلك يسهم في تحديد مسار أهم طرق الإمداد البري التي اعتمد عليها لتوريد الأسلحة إلى لبنان وفي معرفة منشآت التدريب والتسليح والتخزين التابعة له في سوريا وفي توضيح الأهداف الاستراتيجية التي حققها من تدخله في سوريا وطريقة نشاطه عسكرياً وأمنياً وثقافياً واقتصادياً، علماً أنه كان من الصعب تحديد مواقع انتشار الحزب وتوزعه داخل الأراضي السورية لأن وجوده، بخاصة على خطوط التماس الممتدة على مسافات طويلة، ليس وجوداً منفرداً، إنما يكون مع قوات أخرى، إضافة إلى عدم وجود قواعد عسكرية كبيرة له على غرار القوى الأخرى. ويضم ذلك الخط 55 نقطة، في وقت يأتي الانتشار الثاني الأكبر في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد بـ 28 نقطة، تليهما محافظة حمص بـ 15 نقطة، بينما تتوزع بقية النقاط في كل من دير الزور ودمشق والسويداء.
وخلال حديث للباحث في “جسور” وائل علوان في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024، قال إن نفوذ “حزب الله” في سوريا “تهدَّد بصورة فعلية أخيراً بعد سيناريوهات الحرب الإسرائيلية في لبنان والمنطقة”، وأشار إلى أن المواقع التي يتوزع فيها الحزب في سوريا لصيقة بمواقع الميليشيات الإيرانية، مما يعني اعتماد النفوذ الإيراني بصورة كبيرة على “حزب الله”، خصوصاً في محيط حلب وإدلب (شمال) وفي مناطق الساحل السوري والمنطقة الوسطى وبالتأكيد في كامل المناطق الممتدة على طول الحدود مع لبنان.
منطقة القصير “ضاحية جنوبية ثانية”
وتمتد الحدود بين لبنان وسوريا لمسافة 375 كيلومتراً وتعتبر حدوداً طويلة جداً، وفي حديث سابق لأحد أبناء العشائر الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن “تلك الحدود استخدمها ’حزب الله‘ لتهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات والكبتاغون في عهد نظام الأسد البائد وإن الحزب كان يسيطر على عشرات المعابر غير الشرعية للانتقال إلى الداخل السوري والتبديل العسكري إبان الحرب السورية، أضف إلى أن هذه المعابر سيطرت عليها عشائر وأطلقت أسماءها عليها”.
أيضاً وفي حديث سابق لنا مع رئيس اتحاد العشائر العربية في لبنان الشيخ جاسم العسكر قال إن “حزب الله” كان يسعى إلى جعل منطقة القصير “ضاحية جنوبية (الضاحية الجنوبية لبيروت) ثانية في الداخل السوري وكان يشجع أنصاره والمقربين منه على الاستثمار وشراء شقق والتمدد في تلك المنطقة وصولاً إلى حمص”. واليوم هل ما زالت لدى الحزب مواقع في الداخل السوري؟
“فتنة سنية – شيعية”
يقول الإعلامي والمحلل السياسي فادي أبو دية إن ما يحصل على الحدود الشمالية مع سوريا هو “إعادة فرض هيمنة للعصابات المسلحة التي تريد أن تحقق مشاريع تقسيمية وإسرائيلية وبث الفوضى والفتنة الطائفية لأن زج اسم ’حزب الله‘ في إشكاليات كهذه لا علاقة له بها، وأيضاً هي بين مجموعة من اللصوص وهي محاولة للفت الأنظار والإضاءة على الفتنة السنية – الشيعية باعتبار أن هذه الجماعات ذات غالبية سنية و”حزب الله” غالبيته من الشيعة، بالتالي يريدون زج اسم الحزب لأجل هذه الفتنة”، ويتابع أن “الحزب ومنذ بداية وجوده في سوريا لمحاربة الإرهاب التكفيري من أجل حماية لبنان لم يكن موجوداً ضمن مراكز عسكرية معلومة أو معروفة في سوريا، وهذ أصبح واضحاً، بالتالي منذ أكثر من ثلاثة أعوام وبالمعلومات، فإن ’حزب الله‘ قلص عديده بما يقارب 80 في المئة، مما يعني أن وجوده أصبح رمزياً مرتبطاً ببعض الأمور والتفاصيل التي تحتاج إلى حضوره فقط لا غير”.
“عمل الحزب… أمني”
ويشير أبو دية إلى أنه “بخصوص المراكز في الداخل اللبناني فإن هذه المراكز غير موجودة، بالتالي الحزب لا يخطط أو ينوي وليس لديه أي اتجاه نحو العودة لسوريا. والنظام في سوريا الذي كان حليفاً للحزب سقط، بالتالي فإن الحزب يتجه نحو الحضور اللبناني أكثر فأكثر، وحتى في هذه المشكلات هو أصدر بياناً أنه غير معني بكل ما يحصل وليس متورطاً وليس لديه حضور في هذه المعارك. أما بخصوص المراكز فإنها غير معروفة وعملها بشقه الكبير عمل أمني”.
قوات استشارية إيرانية في سوريا
وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 أشارت تقارير صحافية إلى وجود تنسيق بين “حزب الله” وجماعات مسلحة أخرى مدعومة من إيران مثل “حركة النجباء” العراقية التي تنشط في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك دير الزور والرقة، ويعتقد بأن هذا التنسيق يهدف إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة وتأمين المصالح الاستراتيجية المشتركة.
وكان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الجنرال إسماعيل كوثري أعلن عن إرسال بلاده “قوات استشارية إيرانية إلى سوريا” على خلفية الهجوم الذي قامت به الفصائل السورية المعارضة المسلحة في حلب وإدلب حينها. وتحدث مصدران في الجيش السوري الذي كان يتبع للنظام البائد أن عناصر من فصائل مدعومة من إيران دخلت سوريا من العراق واتجهت إلى شمال البلاد لتعزيز قوات الجيش السوري التي كانت تقاتل قوات المعارضة. ونقلت وكالة “رويترز” حينها أن عشرات من مقاتلي قوات “الحشد الشعبي” العراقية المتحالفة مع إيران عبروا من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري قرب معبر البوكمال وأن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل “كتائب حزب الله” العراقية و”لواء فاطميون”. وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية آنذاك، نقلاً عن مصادر في “حزب الله” وميليشيات عراقية موالية لإيران، أن طهران نشرت عناصر من الحزب والميليشيات في سوريا.
خلايا نائمة تتحين الفرص
وسط هذه الأجواء أشار المتخصص في الأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر إلى أنه “في الثامن من ديسمبر عندما سقطت دمشق وسقط النظام السوري وانتهت العمليات العسكرية، تبخرت الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة والجيش السوري وتوجهت إما للعراق أو لبنان وبقي بعضها في الداخل السوري وتحولت إلى خلايا نائمة. وطبعاً غادر قسم كبير من الميليشيات الإيرانية وأبرزها ’حزب الله‘ إلى لبنان، لكن قسماً كبيراً منها بقي في مناطق وجود حاضنة شعبية له مثل الساحل السوري ومناطق العلويين وغيرها وتحول إلى خلايا نائمة تتحيّن اللحظة والفرصة المناسبة لإعادة قلب الأمور لأن لديها إصراراً كبيراً وعدائية شديدة تجاه النظام السوري الجديد أكبر من العدائية تجاه إسرائيل، والخلايا الموجودة في شرق لبنان هي الأكثر تخطيطاً حيث تدور المواجهات مما ينذر بالخطر الشديد إذا لم يجرِ تداركها”.
تطبيق القرار الدولي 1680
ويتابع صخر أن “هناك مآخذ كثيرة على السلطات اللبنانية لأنها تتفاعل بالنتائج ولا تعالج الأسباب، ومعالجة الأسباب تتم عبر تطبيق القرار الدولي 1680، أو الدستور اللبناني، وإذا لم يحصل ذلك فهناك أربعة أفواج برية كاملة الجاهزية مهمتها الحصرية ضبط الحدود اللبنانية، أي أربعة آلاف عنصر. وعندما تكون هناك إرادة وجدية لبنانية لمعالجة هذه الأزمة، فالمعالجة سهلة جداً”، ولفت إلى أن “للحزب خلايا نائمة في الداخل السوري، لكن تخطيطها وأوامرها وتنسيقها ينطلق من شرق لبنان، حيث الحاضنة الثانية للحزب وفلول الأسد التي هربت إلى هذه المنطقة، وبالتنسيق مع جهات عراقية وبأوامر إيرانية تحاول قلب الأمور، وستعاود تكرار ما حصل إن لم تلجأ السلطات اللبنانية والسورية إلى الحزم في المعالجة عبر ضبط الحدود بصورة كاملة تمنع تكرار المواجهات”.
————————————
القرداحة… مهد الأسد وضحيته/ طارق علي
دفعت الثمن مرتين: واحدة بانتمائه إليها وأخرى بإذلاله لأهلها وجعلها أفقر مدن الساحل
الأربعاء 19 مارس 2025
يشكك كثير من السوريين بنسب آل الأسد، وإن كانوا ينتمون فعلاً إلى الطائفة العلوية ومدينة القرداحة أساساً، وهو سؤال كان لا بد من توجيهه لأهالي المدينة أنفسهم.
“كثيراً ما عملت الطائفة العلوية كمرابعين (لقاء أجور يومهم) لدى الإقطاعيين، إلى أن جاء حزب البعث وأمم المصانع والشركات والأراضي فاعتقدنا أن حقبة العبودية انتهت، لكننا وجدنا أنفسنا من جديد مرابعين لدى آل الأسد”. يقول ناصر بركات أحد سكان القرداحة.
يروي الرجل السبعيني رحلة التحول نحو الأسوأ بعد آمال عريضة بنوها على الحزب القائد بقوله “كيف لم نكن لنستشعر أملاً عظيماً والحزب حزبنا كفلاحين وفقراء كما قيل لنا؟ وقائد الحزب من مدينتنا القرداحة، فأي رخاء قادم سنعيشه، لكن سرعان ما اكتشفنا أن تجربة الأسد في تحويل سوريا إلى مزرعة بدأت من مدينته الصغرى وقتذاك، المدينة التي حكمها إخوته وأولاد عمومته وأقرباؤهم بالسياط والقوة والترهيب والجريمة”.
الاختبار الأول للحكم
يكمل الرجل العجوز “فعلياً كانت القرداحة النموذج الأولي لاختبار سوريا اللاحقة، فالجميع يعرف أن البلد غرق بالسلاح والمخدرات في الحرب، أما القرداحة فقد غرقت بهما مع التهريب منذ سبعينيات القرن الماضي، حافظ تمكن منا وأفقرنا، وحول مسقط رأسه إلى شريحتين سكانيتين، ملوك وعبيد، ملوك ينتمون للنسب الصافي من الأسرة الحاكمة، وعبيد هم عامة عائلات المدينة، وهو ما كرسه بشار خلال حكمه غير المتزن”.
في سياق حديثه يحاول ناصر التأكيد غير مرة أن أسرة الأسد لا تنتمي تاريخياً إلى القرداحة أو الساحل السوري أساساً، ويؤكد أن سكان موطنه يدركون ذلك جيداً غير متمكنين من الحديث عنه مرة واحدة بسبب بطش النظام وإمعانه في سردية انتمائه الجغرافي وخصوصيتها في سياق حكمه الذي يشحذ الهمم على أساس طائفي – مناطقي.
من المتعارف عليه أن مسقط رأس عائلة الأسد هو مدينة القرداحة التي تقع على بعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من محافظة اللاذقية الساحلية، وإلى الشرق بنحو 20 كيلومتراً من مدينة جبلة وقاعدة “حميميم” العسكرية الروسية.
تقع القرداحة على هضاب المنطقة الساحلية بارتفاع 400 متر عن سطح البحر، وتتصل عبر شبكة طرق دولية بمحافظات الساحل من طرطوس إلى بانياس فجبلة واللاذقية، وباتجاه حماة وإدلب وسهل الغاب نحو الشرق. وقد عانت المدينة أسوة بغيرها من المدن والأرياف من حال تهميش وبطالة وازدراء وتعويم قيادات محلية إجرامية على حساب طبقة معظمها من المسحوقين اجتماعياً، في حين برزت بها عائلات كبرى كآل إسماعيل الذين لم يصلوا لقوة شخوص آل الأسد، ولكنهم تمكنوا من انتزاع بعض الامتيازات والتعيينات العسكرية، عدا عن العلاقات التجارية وعلاقات المصاهرة العائلية لاحقاً، لتلتحم العائلتان جزئياً في تشكيل قوة ضاربة هيمنت على المنطقة والجوار لعقود طويلة.
يتبع للقرداحة إدارياً عدد من القرى والمزارع من بينها عين العروس مسقط رأس وزير الداخلية السابق غازي كنعان الذي قضى منتحراً في مكتبه قبل نحو عقدين، وقبلها كان قائداً للقوات السورية في لبنان وصاحب اليد الطولى في كل الأحداث هناك. كذلك قرية جوبة برغال التي ينتمي إليها سلمان المرشد زعيم الطائفة المرشدية في سوريا. وأيضاً قرية بستان الباشا التي ينحدر منها رامي مخلوف إمبراطور الاقتصاد السوري وابن خال بشار الأسد، وقرى أخرى من بينها كلماخو ورويسة البساتنة وبشلاما وبكراما والقبو والسفرقية.
وكلمة القرداحة تعني في اللغة مكان صنع السلاح، أو مكان الحديد، لما أبدته هذه المنطقة من مقاومة للعثمانيين والفرنسيين، وفي اللغة الآرامية تعني “القرية الأولى” وهو ما يستدل به بعض الباحثين للدلالة على قدمها التاريخي.
شكوك في النسب
يشكك كثير من السوريين بنسب آل الأسد، وإن كانوا ينتمون فعلاً إلى الطائفة العلوية ومدينة القرداحة أساساً، وهو سؤال كان لا بد من توجيهه لأهالي المدينة أنفسهم.
عامر إسماعيل أحد السكان يخبر “اندبندنت عربية” نقلاً عن أحاديث سمعها في صغره من جده أن “جد حافظ الأسد وفد إلى منطقتهم قبل زمن بعيد، وليسوا متحدرين من المنطقية الجبلية، وأن ذاك الجد بالكاد كان يتقن اللغة العربية، مرجحاً أن يكون قدومهم من مناطق إيرانية أو جبلية في شمال العراق، من دون أن يتمكن أحد من حسم هذه المسألة”.
يتفق مع هذا الرأي كثير من أهالي المنطقة، إذا يقول الطبيب سليمان بركة “لعبة الاستخبارات الغربية جعلت عائلة الأسد جزءاً من المكون الساحلي، لكن لنر على مدار نصف قرن هل كان حافظ وبشار علويين؟ قطعاً لا، هما كانا أسديين وخلقا طائفة أسدية ورطت معها الطائفة العلوية، مستغلين بصورة ممنهجة فقر الناس المدروس وحاجتهم فتركوهم أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها، وظيفة حكومية تقوم على الفساد والحصول عليها صعب، استمرارهم كمرابعين، أو التطوع في الجيش قسراً”.
مما لا شك فيه أنه لا أحد تمكن من إثبات نسب آل الأسد الحقيقي حتى الآن، لكن في الأقل ثمة وثائق تحمل توقيع جد بشار تطالب بالتقسيم والحماية الفرنسية، وهي وثيقة استخدمتها المعارضة في غير مناسبة خلال الحرب السورية للتشكيك بوطنية العائلة بأكملها.
“هناك مثل شعبي شهير في سوريا يقول (بماذا أذكرك يا سفرجل وبكل عضة غصة) وهذا حالنا مع حكم الأسد منذ عهد آبائنا وحتى إسقاط بشار”. هكذا يلخص مراد أحمد ابن مدينة القرداحة حالهم مع حكم الأسد الذي توسموا فيه خيراً كثيراً، “ابن طائفتنا ومدينتنا، لكننا لم نكن ندرك أننا لا نعنيه في شيء”.
يتابع مراد “مهما رويت عن القرداحة في عقودها الماضية قد يبدو أن الأمر لا يصدق، في سوريا كان هناك رئيس واحد، حافظ ثم بشار، أما في القرداحة فكان هناك رفعت وحافظ الآخر ومنذر وجميل وطلال وأنور وهارون وهلال ووسيم وسليمان وبديع وبقية العائلة التي جعلت لقب (شيكاغو) يطلق على المدينة”.
ويستطرد، “كانوا يسيرون بمواكبهم وسلاحهم ومرافقتهم، ويمشون فوق أحلامنا وآمالنا وفقرنا، كانوا يمتلكون قصوراً بديعة يمنع علينا نحن أبناء المدينة الاقتراب منها على الإطلاق أو تصويرها أو اللجوء إليها، وداخلها كانت تعقد كبرى صفقات الأموال”.
ويكمل ابن المدينة، “ربما خلال أعوام حكم حافظ كانت الأمور أكثر هدوءاً، رغم أن انتشار صفة الشبيحة انطلقت من القرداحة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي نتيجة لتوجه آل الأسد لركوب تلك السيارات التي تسمى (شبح) وهي (مرسيدس 500 – إصدار قديم) وفيها كان يتم الخطف والتشليح وتهريب العملة والآثار والسلاح والمخدرات، أما على عهد بشار وظهور جيل جديد من آل الأسد فقد استوحشت العائلة أكثر بكثير”.
عن ذلك التوحش يشرح مراد، “مثلاً سليمان ابن هلال الأسد ابن عم بشار قتل ضابطاً عقيداً على رأس عمله لأنه تجاوزه في إشارة المرور قبل بضعة أعوام، ثم دخل السجن وخرج بصورة طبيعية، كان سليمان العشريني مصدر رعب في اللاذقية كلها، كان يأمر الدبابات لتتحرك في المدينة بقصد التجوال معه. وهناك بشار ابن طلال الأسد الذي كان يقتل خصومه عبر دفنهم بالأسمنت الطري، ووسيم الأسد الذي يعرف الجميع جرائمه، وحافظ ابن منذر الذي يسيطر على سوق مزاد السيارات الفخمة، ولكل واحد من آل الأسد هؤلاء قطاعه وتخصصه وتفننه في إجرامه، عدا عن السيطرة على سوق المراهنات الإلكترونية، والتوسع في أعمال المخدرات وسواها، وكل ذلك كان يتم تحت أنظار بشار الذي لم يقرب العائلة منه على مستوى الخط المباشر واللقاءات المستمرة، ولكنه ترك الباب مفتوحاً لهم للسيطرة على الشمال الغربي من البلاد، وكان كل ذلك يتماشى مع ازدياد فقر الناس وحاجتهم وعجزهم عن شراء ربطة الخبز”.
الثمن المضاعف
أحد ساكني المنطقة، فضل عدم الكشف عن اسمه، بيَّن أن قصور أولئك الأمراء باتت اليوم خاوية على عروشها بعدما هربوا جميعاً، معتقداً أن غالبيتهم بات خارج البلد، ومؤكداً في الوقت نفسه وجود أشخاص من آل الأسد كانوا خيرين مع الناس.
يروي الشاهد صدمة الناس حين اشترى حافظ منذر الأسد سيارة “تيسلا” قبل بضعة أشهر بـ200 ألف دولار بينما كانت العائلات في جواره تبيت بلا عشاء.
قد تكون القرداحة دفعت ثمناً مضاعفاً إبان انتصار الثورة وسقوط نظام بشار، على اعتبار أنها مسقط رأس الأخير، وأن في الجيش نسبة كبيرة من الضباط والجنود من المنطقة وإن كانوا لا يشغلون مناصب مهمة في غالبيتهم، إذ طالما ساد اعتقاد لدى كثيرين أن البلد تحكم من هناك، وهو ما أثبتت الأيام عدم صحته، وأوضحه انتصار الثورة جلياً.
أحد مقاتلي غرفة “ردع العدوان” التي حررت سوريا قال لـ”اندبندنت عربية”، إنهم توقعوا مقاومة شرسة وغير مسبوقة في القرداحة، لكنهم فوجئوا بأناس مدنيين طيبين ومنهكين من الفقر والجوع والحاجة والعوز لأبسط مقومات الحياة.
ويضيف، “لم تكن كما توقعناها. بيوت فقيرة وبسيطة وخالية من مقومات الحياة، يقابلها بضعة قصور لمجرمي عائلة الأسد، حتى إن بعض الثوار حين دخلوا مرقد حافظ الأسد لم يعترض الناس في المنطقة رغم ما طاوله من تخريب، شعرنا بأن الناس ناقمة مثلنا على هذه العائلة، إحدى الأمهات أخبرتني أنهم اعتقلوا ولديها من دون أن تعرف تهمتهما أو مصيرهما رغم مضي السنين، وأن الأسد كان يجبر الناس على القتال”.
وفي الإطار لم يسلم أهل مدينته من بطشه فعلاً، فلا يزال السوريون يتأسفون على اعتقال المعارض البارز عبدالعزيز الخير وتغييبه قسراً رغم مضي أكثر من 10 أعوام على اختطافه من دون معرفة مصيره، في حين رجحت مصادر خاصة لـ”اندبندنت عربية”، أن المهام الخاصة في الاستخبارات الجوية هي من قامت باعتقاله وتصفيته لدوره الخطر على الأسد، كان ذلك عام 2012 خلال عودته من مطار دمشق الدولي إلى الداخل السوري.
ليال حمراء وجوعى
منيرة (اسم مستعار لسيدة ستينية من القرداحة) تروي لـ”اندبندنت عربية” كيف اُقتيد ابنها عام 2014 للخدمة العسكرية الإجبارية عند أحد الحواجز، ولاحقاً تم إرساله للقتال في دير الزور شرق سوريا.
تمكنت السيدة بعد توسل وتضرع لأحد أفراد عائلة الأسد من إقناعه بـ”تفييش” ابنها على أن يعمل لديه في القصر، وبالفعل “حن قلبه عليها” كما تقول، واستقدمه من الخدمة على الجبهة ليكمل جنديته كخادم في منزل الأمير الجديد.
تقول المرأة، إنه كان على ابنها تحمل نزق ذلك الأسدي وحالات سكره ومجونه وعربدته وتنفيذ طلباته الغريبة، لكن ذلك كان أفضل من إرسال معيلها الوحيد إلى الجبهة حيث يموت ليحيا الأسد.
السيدة روت على لسان ابنها ما كان يحصل من سهرات وليال حمراء يومية يتم فيها استقدام فتيات مختلفات وعليهن يجري رمي كثير من الأموال باليورو والدولار خلال رقصهن، حتى إن ما يصرف في سهرة واحدة من تلك كفيل بإطعام القرية لأيام.
المرأة رفضت تسمية الشخص الذي خدم ولدها عنده خشية الانتقام، قائلة “ربما لهذا الشخص فلول لا يزالون بيننا”. مضيفة “بأموالهم اشتروا طاعة الناس، الحاشية الدموية المحيطة بهم في الأقل، نحن نعرف أنهم غير محبوبين كأشخاص، لكن حاجة الناس إلى المال والعيش جعلتهم محاطين بالدروع البشرية والعناصر المسلحة، وكان ابني كحال غيره من الخدم، لا يحتسب على الحاشية ذات الولاء، بل كان دوره مجرداً بالمهام المنوطة به من استقبال وتوزيع الضيافة، لذا لم يكن شريكاً في المشبوهات ولا ممن يغدق عليهم المال، كان السيد يرى أنه أحاط عائلتنا بفضله ومنه وكرمه بأن خلص ولدي من الجيش، لذلك يجب أن يكون ابني مديناً طوال العمر، وأن يحفظ أسرار ما يدور في منزل سيده، هكذا فعل بنا بشار، جعلنا سادة وخدماً”.
وتتابع، “لم يمر يوم من دون أن أرى نظرات القهر في عيني ولدي، وتنامي حقده على ابن العائلة الحاكمة، حقد يرجع للأسباب التي جوعت مدينة بأكملها ليعيش بعض أفرادها ملوكاً. يقول لي ابني إن أشهى المأكولات كانت ترصف على الموائد الكبيرة، اللحوم والدجاج والذبائح والحلويات والمكسرات وكل ما يشتهيه السوريون، بل ما يشتهيه أقرب جيرانهم إليهم”.
وتختتم حديثها بالقول، “كان قانون قيصر يطبق علينا فنموت جوعاً، أما موائدهم وسياراتهم وقواربهم البحرية وأرصدتهم المالية وسيجارهم الأجنبي، كل ذلك كان متاحاً وهم يعبرون الطرقات ذات الحفر ويرون أرتال الناس تصطف للحصول على معونة أو خبز من دون أن يرف لهم جفن. الناس في مسقط رأس الأسد تكرهه، الناس في كل البلاد باتوا مع الوقت يكرهونه، وكما نقول في الساحل (من ليس فيه خير لأهله ليس فيه خير لأحد). أو لسنا نحن أهله؟ أم إننا خاصته في الحروب والموت وحين توزيع الغنائم نصبح غرباء نبحث عن نقطة طبية تداوينا، وعن وسائل نقل تقلنا وعن وظائف لا امتهان لكراماتنا فيها، هل أتحدث كيف كانوا يعتدون على الحرمات أيضاً؟ لا شيء غير مباح لهم، حتى القانون في صفهم ظالمين أم مظلومين”.
لا امتيازات للعامة
يحاول الشيخ ثائر ديوب وهو ابن مدينة القرداحة نفي التهم التي كانت توجه لمدينته، بل وتوضيح الصورة الحقيقية للحال التي كانت يعيشون فيها، مبيناً أن أهل المدينة كانوا يعملون في الزراعة والأعمال اليدوية والجيش والبعض عند آل الأسد.
ويشير إلى أن المدينة التي كانت مغيبة عن الإعلام طويلاً لم تكن تحظى بأي امتياز إضافي عن سواها، بل إن مدناً أخرى فاقتها بسنين كثيرة في التطور والعمران والخدمات، ويستذكر على سبيل المثال مدينة دير عطية في ريف دمشق التي ينحدر منها مدير المكتب التاريخي لحافظ وبشار قبل وفاته منذ بضعة سنين أبو سليم دعبول، حيث جعل من الحاضرة التي ينتمي إليها (دير عطية) قبلة في البناء والمال والأعمال والصروح الحضارية. وكذلك مدينة مشتى الحلو في ريف طرطوس بفضل جهود مغتربيها وأبنائها، وقمحانة في ريف حماة، وغيرها، وللمفارقة فإن دير عطية في ريف دمشق كانت تسمى قرداحة القلمون، وقمحانة تسمى قرداحة حماة.
ويضيف، “لا أدري من أين جاءت تلك التسميات المجحفة مقارنة بمدينة ينهشها الفقر وسوء الخدمات والعيش خارج سياق القانون وخضوعها للأعراف المرهونة بمتنفذي آل الأسد الذين هم خارج قوانين المحاسبة القضائية والجنائية. هل من المبالغ به أن أقول إن شعب القرداحة من أفقر سكان المنطقة، هذا ما أراده الأسدان لإقناع الناس بارتباط مصيرهم بهما، وبأنه لا حياة لهم من دونهما، لذا لم يعترض أحد على تخريب قبري حافظ وابنه باسل، هذه العائلة ركبت المنطقة والطائفة وقتلتهما من الجوع والحاجة، لا اتصالات، لا نقل كما يجب، لا أساسيات، فقر طاغ”.
أهال من القرداحة والمنطقة لم يستبعدوا خلال حديثهم مع “اندبندنت عربية” وجود فلول للنظام في المنطقة، مبينين أنهم “أقلية لا وزن لها، لكنهم كذلك مجرمو حرب، يهربون بين الجبال والأحراش ويجرون المنطقة لنزاعات هرباً من تطبيق العدالة بحقهم”، ومؤكدين في الوقت ذاته أنهم مندمجون تماماً مع الإدارة الجديدة، لكن شرط أن تتوقف الانتهاكات وتعاد للناس كرامتهم ويفهم الحكام الجدد أن السكان هنا بسطاء لا يريدون حرباً، فغريمهم وعائلته ومناصروه هربوا ولم يبق إلا من يبحث عن قوت يومه. داعين أن تصل تلك الرسالة للدولة الجديدة قبل غيرها، وأن يفهم العقلاء ويفهموا الناس أن القرداحة جزء من الساحل وليست المسؤولة عن الطائفة العلوية من قرى الجولان إلى دمشق فحمص وحماة والساحل وصولاً إلى لواء إسكندرون.
صيت بلا صدى
يرى المهندس محمد زهرة ابن قرية عين العروس التابعة إدارياً للقرداحة، أن الأخيرة “صيت بلا صدى”، ويتساءل “أليس غريباً أن يجمع كل الناس على رأي واحد؟ الجميع في مناطقنا يؤكد حال الفقر العامة، والأسوأ أننا نرزح تحت تشبيح جماعات آل الأسد، أقصد قبل سقوط النظام. اللواء غازي كنعان من قريتنا فماذا استفدنا منه، هل أصبحت بلدتنا يجوبها الغنى وصارت قبلة سياحية؟ كذلك القرداحة”.
ويتابع، “لقد حملنا النظام فوق طاقتنا، ذاك النظام لم يكن يعرف علوياً وسنياً، كان يعرف موالياً أعمى ومعارضاً خطراً، وخلال الحرب شحن الناس والطائفة وأفهم الجميع أن بقاءه يعني حياتهم، ورحيله يعني موتهم، وتركهم أمام خيارات ضيقة للقتال بعدما عوم البطالة ولم يترك لهم سبلاً للعيش الكريم، لم يقاتل الجميع عن قناعة بل عن حاجة، لذا نرى مئات الآلاف من الخريجين الجامعيين بلا عمل، بينما الكلية الحربية تقبل الجميع وتمنحهم رواتب مباشرة، رواتب مقرونة بسقف الحلم الذي صار يتمثل بالخط العسكري على دور الفرن ومحطة الوقود، اسأل جميع أهل القرداحة ليخبروك أي جحيم دفعوا ثمنه لقاء انحدار قائد من مدينتهم التي لا يزورها ولا يفكر في لجم ثيرانها الهائجين على الناس حتى، ذلك جزء من فرض السيطرة، جزء مدروس ربما”.
أما الباحث في التاريخ الحديث فجر الحكيم، فيوضح لـ”اندبندنت عربية” أنه يمكن حصر الأشخاص الذين تسلموا رتباً ومناصب رفيعة من القرداحة قياساً بمناطق كثيرة أخرى، وأن الأسد الأب ومن خلفه الابن اعتمدا بصورة مباشرة على ولاءات سنية مكنت لهم أسباب الحكم واستتبابه، على رأسهم العماد أول وزير الدفاع لعقود مصطفى طلاس، ورئيس الأركان حكمت الشهابي، وعبدالحليم خدام، ومرافق حافظ الشخصي خالد الحسين وأبوسليم دعبول مدير مكتبه، ورؤساء حكوماته التاريخيين عبدالرؤوف الكسم ومحمود الزعبي. كذلك الاعتماد على محمد حربا لإدارة وزارة الداخلية لأعوام، إضافة إلى مناصب سليمان قداح، وفاروق الشرع، وفيصل المقداد، ووليد المعلم، وبالطبع زوجة بشار الأسد أسماء الأخرس، مع قريبها طريف الأخرس، وما لحقهم في عهد الابن من الاعتماد على مصطفى ميرو، وناجي العطري، وعماد خميس، ورياض حجاب، ووائل الحلقي، وحسين عرنوس في رئاسة الحكومات، ومن بين أبرز رموز الأمن علي مملوك رئيس جهاز الأمن القومي، وهشام اختيار الذي سبق مملوك في المنصب، ومحمد الشعار في وزارة الداخلية، وديب زيتون في إدارة أمن الدولة، والأسماء لا تنتهي، وكلها تنتمي للأكثرية”.
هذا لا يعني أن الأسدين لم يعتمدا على العلويين، وفق الحكيم، ولكنهما اعتمدا على السنة كثيراً أيضاً، كان الولاء هو المعيار، لذلك لقيت كلمة وزير الخارجية أسعد الشيباني أخيراً خلال مؤتمر المانحين في بروكسل كل تلك الضجة في الشارع السوري، حين قال إن حكم الأقليات لسوريا أفضى لتهجير 15 مليون سوري وقتل مليوناً آخرين، ليعترض الناس على توصيف كهذا يخرج من وزير خارجية محنك يعلم أن الذي حكم البلد هم الطغمة الأكثر ولاء من كل الطوائف، الذين شربوا من الدم السوري بصرف النظر عن مرجعيتهم الطائفية والعرقية.
ويضيف الباحث، “ما قاله الوزير هو سقطة في حق سوريا وشعبها وقصر في النظر السياسي والاستراتيجي، سوريا لم تحكم يوماً من قبل أقلية، وإلا لماذا استشرى الفقر بين الجميع فيما كان يتسيد عليهم أمراء حرب من كل الطوائف، لم يعرف الامتياز يوماً فرقاً في التوزيع بين شخص وآخر بصرف النظر عن طائفته لقاء ما يقدر أن يقدمه من خدمات للنظام البائد، ففي حين كان الشعب السوري يموت جوعاً كان حمشو وقاطرجي والفوز وغيرهم ومعهم علويون بالتأكيد، يتنعمون بخيرات البلد”.
—————————————
سوريا إلى أين؟/ بكر صدقي
تحديث 21 أذار 2025
من واكب التطورات السياسية في سوريا ما بعد نظام الأسد لا يخفى عليه تخبط المجموعة الحاكمة الجديدة أمام التحديات الهائلة التي خلّفها النظام المخلوع. بات وراءنا الآن أكثر من ثلاثة أشهر لم تسجل خلالها الإدارة الجديدة أي تقدم في أهم الملفات كالأمن والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي وتفكيك الفصائل المسلحة وتوحيد الجغرافيا السورية والمجتمع السوري.
لقد انبهرت هذه السلطة بسرعة توليها السلطة في اثني عشر يوماً، وبالقبول العربي والإقليمي والدولي الواسع والسريع بها، كما بقبول غالبية اجتماعية قام قبولها على الالتفاف حول الإنجاز الكبير المتمثل في إسقاط النظام. وفي حين تدين السلطة لسرعة إسقاط النظام بظرف إقليمي استثنائي هو ارتدادات عملية «طوفان الأقصى» وتداعياتها الكارثية، قام القبول العربي ـ الإقليمي ـ الدولي على رغبة الدول المعنية باستعادة الاستقرار الذي طال غيابه 14 عاماً وتسبب بتداعيات خطيرة وصلت آثارها إليها، كمشكلات الإرهاب وتدفق اللاجئين والمخدرات والأعباء الاقتصادية المرتبطة بها. أما القبول السوري العام فكان أساسه الفرح العارم بسقوط النظام وما عناه ذلك من انفتاح الأفق أمام تأسيس جديد يقطع مع الماضي الكارثي، إضافة إلى الأداء المقبول لهيئة تحرير الشام وحلفائها أثناء عملية «ردع العدوان» وبخاصة في مناطق حساسة كحلب ودمشق وجبال الساحل، حيث لم تشهد المعركة عمليات انتقامية واسعة النطاق أو أعمال عنف على أساس طائفي أو تضييقاً واسع النطاق على الحريات العامة والخاصة.
غير أن كل ذلك راح ينقلب إلى تراجع في شعبية الفريق الحاكم بمرور الأيام، بدءاً بمسرحية «مؤتمر الحوار الوطني» الهزلية وصولاً إلى المجازر الطائفية في الساحل مع الأسبوع الأول من شهر آذار الجاري، وأخيراً إصدار الإعلان الدستوري الذي لاقى انتقادات واسعة، فطغى على المشهد السياسي غياب الثقة بين قطاعات واسعة من المجتمع لا تقتصر على العلويين أو الأقليات، مقابل ارتفاع منسوب العدوانية اللفظية لدى مؤيدي السلطة الجديدة في مواجهة أي نقد لمسالكها حتى فيما اعترفت بها هي نفسها وشكلت «لجنة تقصي حقائق» بشأنها. مجمل القول هو أن الرصيد الكبير (المشروط) الذي حصلت عليه السلطة الجديدة في الداخل والخارج آخذ في التآكل كل يوم مع تراجع الآمال التي عقدت على التحول الكبير الذي تمت المراهنة عليه.
لن أدخل في تفاصيل نقد الإعلان الدستوري الذي قام به كثر وشمل مختلف مفرداته، ولكن من الطريف الإشارة إلى بند يتعلق برئاسة الجمهورية حيث ورد فيه شرط يتعلق بدين رئيس الجمهورية من غير أي إشارة إلى جنسيته، ربما لأن اللجنة الدستورية التي عينها الشرع لم تخطر ببالها هذه الثغرة الخطيرة حتى لو تعلقت باحتمال قريب من الصفر. فوفقاً لهذا الشرط يمكن لأي مسلم أن يشغل منصب رئاسة الجمهورية حتى لو كان غير سوري الجنسية، مع العلم أن هيئة تحرير الشام وفصائل جهادية أخرى فيها أعضاء أجانب من جنسيات مختلفة، وبينهم من تم تجنيسهم على عجل وبصورة غير معلنة!
لعل غموض أجندة الفريق الحاكم، وبخاصة قائده أحمد الشرع، في مسائل أساسية كشكل الدولة ونظام الحكم وغيرها، هو ما شجع كثيرين على المراهنة على تغيير لا بد أن يطال برنامجهما الأيديولوجي المعروف القائم على الفكر السلفي والنزعة الطائفية السنية. لكن هذا الغموض لم ينجلِ في الفترة المنصرمة إلا عن أسوأ الكوابيس التي استبعدها السوريون، فتفجر العنف الطائفي واتضحت الميول السلطوية والإقصائية من غير أن يظهر ضوء في نهاية النفق حتى لو كان طويلاً بحكم حجم المشكلات الهائل وضعف وسائل معالجتها.
وعلى رغم هذه المؤشرات المقلقة، يبقى أن السلطة ما زالت ضعيفة وهشة (وهذا بدوره مقلق) وخاضعة لاشتراطات كثيرة أغلبها للأسف خارجي، ستكون مرغمة على التعاطي الإيجابي معها لاستكمال شرعيتها المنقوصة، ولحل مشكلة العقوبات المفروضة على سوريا التي لا تسمح بإطلاق عجلة الاقتصاد، ولا يمكن للسلطة أن تحافظ على ما تبقى لها من شعبية قبل ذلك.
تطفو على السطح، في الحراك الاجتماعي السوري، مشكلة «المكوّنات» التي فشلت السلطة في إدماجها لأنها لم تر في السوريين إلا مكوّنات طائفية وعرقية وثقافية وسعت إلى التحايل عليها بدلاً من معالجتها بروح وطنية. بدا الاتفاق الذي وقعته السلطة مع قسد وكأنه «تاريخي» في أعقاب مأساة أهل الساحل، لكن الإعلان الدستوري بالصورة التي صدر بها قد أضعف من تاريخيته المحتملة، فلا رضيت عنه قسد ولا تيار وازن من دروز السويداء بقيادة الشيخ حكمت الهجري.
لا يمكن للمغمغة بشأن ديمقراطية الدولة وعلمانيتها، وهما شرطان لازمان لقيام دولة في سوريا تمثل جميع مواطنيها، أن تؤسس لهذه الدولة المأمولة، حتى لو تجنب أركان السلطة الكلمتين بذاتهما بحكم الإيديولوجيا التي تحكم تفكيرهم. ما لم تمض السلطة في هذا الاتجاه، ولو بخطوات بطيئة، نخشى سيناريوهات كارثية كتقسيم البلاد أو الحكم بالعنف المعمم مع شعبوية قاتلة. ويحتاج الفريق الحاكم إلى تحالف عريض مع فئات اجتماعية واسعة ليتمكن من تأسيس شرعيته. في حين أن الاستفراد بالسلطة والعجز عن تفكيك الجماعات المسلحة وتوحيد مناطق البلاد هو السائد إلى الآن. سوريا ليست بخير.
كاتب سوري
القدس العربي
——————————-
عن موتنا الذي هو “أفضل المتاح”/ بلال خبيز
21 مارس 2025
يبدي مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، ملاحظة قاسية، لكنها في محلها تماما، معلقا على مجازر الساحل السوري التي جرت في شهر آذار/ مارس من العام الحالي، حين يقول: إن مجازر الساحل السوري موثقة بالصوت والصورة، بعكس مجازر حماة. مصدر القسوة يصدر من واقع أن مجازر حماة كانت أكثر اتساعا وشمولا من مجازر الساحل. مع ذلك، وحيث أن التوثيق لها غير متوافر فإن المحاسبة تصبح أصعب، وتسمح بنجاة من كانوا من أبطالها القتلة. ومصدر وقوع هذه الملاحظة في محلها تماما، يأتي من واقع أن توثيق المجازر يتيح للضحايا وأهلهم الأمل بعدل ولو بعد حين.
إنما يبقى السؤال الأخطر مشهورا فوق رؤوسنا كسيف. من هم هؤلاء الذين وثقوا المجازر؟ كيف يمكن لقتلة أن يصوروا جريمتهم بهذا الفخر؟ سيخرج من بين الناس من يقول: هذا دليل أن المجازر مفبركة. أو أن القتلة تلبسوا لبوس المتهمين بالقتل توخيا لحشرهم في موقع المدان. لكن الثابت أن بعض القتلة صوروا جرائمهم. وهذا في حد ذاته يجدر به أن يكون مقلقا لكل الناس في سائر أرجاء الكرة الأرضية. ذلك أن مثل هذا القتل المصور، والخطاب الذي يعلنه القتلة، بوصفه سببا لاستحقاق الضحايا العقوبة المنزلة بهم، يستند إلى صور أخرى ووثائق أخرى تصور مقتل أبرياء يدعي قتلة اليوم أنهم يثأرون لهم.
المشكلة أن الصور والفيديوهات لا تموت بمرور الوقت، خصوصا إذا كانت الجرائم تحصل في بلاد تشبه بلادنا. ما زال فيديو ذبح أبو مصعب الزرقاوي لنيكولاس بيرغ حاضرا، ويمكن لأي متحمس التحجج به ليقتل من يعتبرهم أهل القاتل وعزوته، فيؤذيه ويؤلمه وهو في قبره.
والمشكلة أن أهل بلادنا يشبهون بعضهم في البؤس والحاجة والفاقة، فلو قام قاتل بتنفيذ جريمة في برج ترامب بنيويورك، فإن هذه الحادثة ستكون مؤرخة بالدقيقة والساعة واليوم. ذلك أن الأماكن المعولمة التي تشبه برج ترامب تغير جلدها كل يوم. المقتول في مكان كهذا لا بد وأنه يحمل ساعة أو هاتفا يشير إلى استحالة قتله قبل موعد إصدار هذه الفئة من الهواتف والساعات، وقد يكون مرتديا ثيابا رائجة لم تكن موجودة قبل شهر من الحادثة. الأماكن المعولمة تستطيع الادعاء أنها معاصرة. لكن قرانا ودساكرنا بحسب هذا المنطق تعيش في أوقات غبرت منذ دهر. وصور الجرائم التي تحصل فيها لا تاريخ لها إلا إذا كانت الضحية نفسها تعيش في زمن العولمة. هذا أيضا يقع في ما يمكن وصفه بعنصرية العولمة الفاقعة. لكن هذه العنصرية قد تكون أقل مشكلاتنا خطرا.
نعيش في زمن معولم. الصحافيون والموثقون يستخدمون أدوات توثيق وإخبار حديثة تماما. لكن الناس الذين يوثقون موتهم يعيشون في زمن مضى. كما لو أنهم تماما فائضون عن الحاجة. هذا يفسر سرعتنا في ارتكاب الفرح الغامر ما أن يحدث حدث كبير في المحيط. نريد أن ننسى قتلانا، لأننا نحن أيضا نعتقد أنهم يعيشون في وقت فائض. حياتهم بالنسبة لنا ليست أكثر من محاولة حشرهم في العتم والصمت، ونسيانهم حتى تميتهم الطبيعة أو يتوفاهم الله. السيدة أم أيمن التي حرست جثث ابنيها وحفيدها في خلفية دارهم، في قرية قبو العوامية، لم تكن لولا الجريمة لتذكر في أي كتاب أو تحقيق صحافي. هذا لا يقع في خانة لوم الصحافة والكتابة. لكنه يقع في خانة لوم حمى العولمة والمعاصرة. هذه المرأة قالت ما قالته للقتلة بينها وبينهم. أدوات العولمة هي التي رفعتها من مصاف المنسيين إلى مصاف المعاصرين. ولأنها كانت تعيش في زمن سابق على زمننا، فإن المدافعين عنها يجدر بهم أن يكونوا من المعاصرين. وإلا فإن مقتل ابنيها وحفيدها كان ليؤرخ بوصفه دعوة للثأر حال التمكن. لا أكثر ولا أقل.
لو لم تحدث الجرائم لما كان في وسع أي كان أن يصف يوميات أهالي هذا الريف المغرق في محليته. هل ثمة رعاية صحية مناسبة يتلقونها؟ هل يستطيعون تأمين قوت يومهم؟ هل يفكرون في مستقبل مشرق ومضاء؟ الأرجح أن كل هذه الأسئلة لن تخطر ببال مشاهد الجريمة المتضامن مع ضحاياها، والأرجح أن أولادها أيضا كانوا ليهاجروا إذا واتتهم الفرصة، ويتركونها وحيدة مع زمنها الذي لم نعد نعرف كيف نعيش فيه.
كل هذا الظلم يقع على هؤلاء دفعة واحدة. منذورون للحداد والموت والهجر والنسيان. ولا يذكرهم العالم إلا حين يقتلون أمام الكاميرات.
ثم ماذا؟
السؤال الأخطر يتعلق بأولاد المرأة المقتولين. لماذا لم يقتل القتلة المرأة أيضا؟ لأنهم على الأرجح يريدون منها أن تدخل في وقت الحداد. الرجال؟ يجب إبادتهم عن بكرة أبيهم. لأنهم إما قتلة وإما مقتولين. الوظيفة الأبرز التي يمارسها الرجال في هذه البلاد ليست أكثر من القتل والتعرض للقتل. ما الذي بقي لهم لينجزوه؟ بضع مجازر أخرى، أو التعرض لمجازر ثأرية أخرى؟ يبدو أننا نعيش حقا في عالم يصعب أن يكون قابلا لأن نتفاهم مع حيثياته. هذا يمتد من سورية إلى لبنان إلى فلسطين إلى اليمن، إلى كل مكان من هذا العالم لا تلمع أضواءه أمام أعين السياح المبهورين.
لكن هذا كله لا يختصر المعضلة.
المعضلة أن صور المجازر التي تبثها وسائل التواصل وشاشات التلفزيونات، تجعل منا كائنات ضيقة الآفاق. كل منحاز يملك صورا لمن يريد الانتقام لمقتلهم. المدافع عن الأسد لديه صور مقتوليه، والمدافع عن الإدارة الجديدة لديه صور مقتوليه أيضا. والحال فإن المجازر مرشحة لأن تشتعل كل لحظة، ما أن يتمكن الراغب في الثأر من تنفيذ ثأره. هذه بداوة معاصرة فرضتها العولمة المنتشية. لكن المقيمين فيها لا يملكون مزايا البداوة المتعلقة بالصلح والدية وتجنب القتل ما أمكن. إنه عالم يأخذ من تاريخ البشر أسوأه وينصبه علما على قناعاته وأفكاره وانحيازاته.
هل في وسعنا بعد هذا كله أن نستغرب أن يصل شخص مثل دونالد ترامب إلى رئاسة الدولة المهيمنة على أذواقنا واقتصادنا ومستقبلنا وأمننا؟ لا يجدر بنا أن نبدي استغرابا. ترامب نفسه هو وليد هذه العولمة التي تصنع الانحيازات القاطعة. كل علوي هو مشروع مجرم في ذهن من يناصبه العداء، كل سني هو مشروع إرهابي في ذهن من يناصبه العداء. وكل مكسيكي هو مشروع تاجر مخدرات في ذهن أنصار ترامب ومؤيديه، وكل أبيض هو عنصري بغيض في ذهن من يناصب البيض العداء. هذا العالم في مركزه يتحول إلى قبائل تريد أن تحارب المخالف والمغاير والآخر. وهذا العالم يبدو أنه يسير حثيثا لقتل من لم يصل بعد إلى مرحلة التحزب الأعمى، ثم بوسعه أن يحتفل بمقتل هؤلاء ويدين قتلتهم، مثلما قد يحتفل بمقتل أعدائهم ويدين قتلتهم. المهم أن تجد لك أيها الإنسان، أيها العالمثالثي، مكانا صغيرا في موقع من يستطيع أن يدين، وأن تتجنب الوقوع في موقع من تقع عليه الجريمة موضوع الإدانة.
ضفة ثالثة
—————————————-
الساحل أمام هجمات جديدة.. أقل فعالية
تحديث 21 أذار 2025
مر نحو أسبوعين على هجمات فلول النظام السابق التي استهدفت عناصر “إدارة الأمن العام” ووزارة الدفاع، ما تسبب بموجة عنف في الساحل السوري.
ورغم إعلان وزارة الدفاع نهاية عملياتها العسكرية، فإن الكمائن وهجمات الفلول لم تتوقف وسط تراجع حدتها نتيجة الاستنفار والعمليات الأمنية.
الهجمات على القوى الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية ليست وليدة أحداث الساحل التي بلغت ذروتها بين 6 و8 من آذار الحالي، لكن هجوم 6 من آذار كان الأوسع والأشمل.
وبعد أيام من سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، بدأت دوريات ومجموعات “إدارة الأمن العام” بالتعرض لهجمات وكمائن في مناطق الساحل وريفي حمص وحماة.
هل من هجمات كبيرة
تساعد الطبيعة الوعرة في المنطقة فلول النظام في تنفيذ هذه الهجمات، حيث توجد جبال ووديان وكهوف يمكن الاختباء بها وإخفاء الأسلحة، إلى جانب الأشجار التي توفر غطاء طبيعيًا لتحركاتهم.
وأوضح الباحث في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة” نوار شعبان أن هجمات الساحل ستستمر وتتكرر في الفترة المقبلة لكنها لن تكون بنفس حجم هجوم 6 من آذار، الذي كان مخططًا لتحقيق مكاسب، وهو ما فشل به.
وأضاف شعبان لعنب بلدي أن ملف الساحل ما زال مفتوحًا، وصد الهجوم لا يعني أنه نهاية الخطر بشكل أساسي، “على العكس، يمكن أن يتحول الأمر إلى هجمات عشوائية مستنزفة هنا وهناك”، وهذه الهجمات منهكة للقوات الحكومية خاصة إذا حدث هجمات متزامنة عبر الحدود اللبنانية أو في مناطق أخرى.
وطالما أن الخطر قائم يجب التعامل معه من ناحية الأمنية وتستمر الملاحقات، وفق شعبان.
ذئاب منفردة
تلجأ التنظيمات المسلحة بمختلف إيديولوجياتها إلى توجيه ضربات عسكرية ضد خصومها، عبر مجموعات صغيرة لا يزيد عددها عن خمسة عناصر، وباستخدام أسلحة خفيفة وعبوات ناسفة، هذه الخلايا يطلق عليها مصطلح “الذئاب المنفردة”.
برعت في هذه العمليات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، ونجحت في توجيه ضربات خاطفة في عمق مناطق سيطرة خصومه سواء في سوريا أو العراق.
ويرى شعبان، أن خيار تحول فلول النظام إلى تنفيذ هجمات ذئاب منفردة أو خلايا نائمة هو المتاح حاليًا، والضربات التي ينفذها عناصر الفلول حاليًا عبر نصب كمائن على الطرق وقرب الجسور والفرار بسرعة يؤكد أنهم انتقلوا إلى مرحلة أخرى.
بداية الهجمات
الهجمات على القوى الأمنية والعسكرية من قبل فلول النظام السابق بدأت بعد أيام من سقوط نظام الأسد، ووصلت إلى مرحلة أسر عناصر من “إدارة الأمن العام”.
في 14 من كانون الأول 2024، أي بعد ستة أيام فقط من سقوط النظام، قتل ثلاثة عناصر من “إدارة العمليات العسكرية” وأصيب آخرون بكمين مسلح بريف اللاذقية.
وقتل 14 عنصرًا من وزارة الداخلية وأصيب 10 آخرون، إثر تعرضهم لكمين من قبل فلول النظام السابق في قرية خربة معيزة بريف طرطوس، في 26 من كانون الأول 2024.
وأسرت مجموعة مسلحة تابعة لفلول النظام السابق سبعة عناصر من “إدارة الأمن العام” خلال تنفيذ حملة أمنية في جبلة، بتاريخ 14 من كانون الثاني الماضي.
حينها استنفرت الإدارة القوات الأمنية والعسكرية واستخدمت الطيران المسير والمروحي في ملاحقة الفلول، واستطاعت تحرير عناصرها وقتل قائد في مجموعات فلول النظام، وهو بسام حسام الدين قائد ميليشيا “أسود الجبل”.
هجمات الفلول مستمرة لكن وتيرتها تراجعت بعد أحداث الساحل الأخيرة، وما رافقها من حملات أمنية.
ولتقليل من خطر هذه الهجمات، يجب على الإدارة العسكرية والأمنية في حكومة دمشق، اتباع عدة إجراءات وفق شعبان هي:
تعزيز القوة الاستخباراتية لجلب المعلومات.
تعزيز التواصل مع وجهاء المناطق.
الاستمرار بالحملات الأمنية ومحاولة تحييد الحاضنة الشعبية بشكل أساسي، لأن الفلول سيعتمدون على زج الطائفية وتصعيد المشهد الطائفي في المنطقة وهي إحدى أدواتهم حاليًا.
هجوم الساحل
في 6 من آذار، هاجمت مجموعات من فلول النظام السابق نقاطًا وحواجز لـ”إدارة الأمن العام” وقطعًا عسكرية تتبع لوزارة الدفاع، ولم تسلم المستشفيات وحتى سيارات المدنيين من هذا الهجوم.
حوصر خلال الهجمات عناصر من وزارة الدفاع و”إدارة الأمن العام” وسقط العشرات منهم إلى جانب مقتل مدنيين، وقوبل ذلك بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لإيقاف الهجوم وفك الحصار، ورافق التعزيزات توجه مجموعات عسكرية إلى المنطقة دون تنسيق واضح مع وزارة الدفاع أو الأمن العام.
الاشتباكات احتدت بين الطرفين، واستطاعت أخيرًا القوات الحكومية السيطرة على الموقف، لكن أدت العمليات العسكرية إلى مقتل مدنيين.
الرئيس الشرع حمّل فلول النظام السابق من “الفرقة الرابعة” التي كان يقودها ماهر الأسد، ودولة أجنبية متحالفة معهم (لم يسمِّها)، مسؤولية سفك الدماء في الساحل السوري، لإثارة الاضطرابات وخلق فتنة طائفية، مع الإقرار بحدوث عمليات انتقام تلت ذلك.
“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت مقتل 803 أشخاص في الفترة ما بين 6 و10 من آذار، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع)، و211 مدنيًا بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، والتي هاجمت أيضًا ستة مستشفيات في طرطوس واللاذقية.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليًا لوزارة الدفاع).
الرئيس الشرع شكل في 9 من آذار لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، مهامها الكشف عن الفاعلين في عمليات قتل المدنيين خلال العمليات العسكرية، إلى جانب مهام أخرى، لكن هذه اللجنة من المتوقع أن تواجه عوائق في عملها.
————————————
لماذا لا تعترف المذاهب الدينية بالكراهية فيما بينها، ولماذا لا تبني نظاماً يلجم هذه الكراهية؟/ غسان صليبي
تحديث 21 أذار 2025
المجازر في الساحل السوري تفتح مجدداً النقاش حول علاقة المذاهب والطوائف الدينيّة فيما بينها، ليس في سوريا فقط بل في المشرق العربي ككل وفي لبنان تحديداً. الذهول من شدة العنف المذهبي، ترافق مع اكتشافنا مجدداً عمق إنكارنا للمشاعر المذهبيّة والطائفيّة.
يعالج هذا النص مسألة الإنكار هذه. جرت التغطية على المسألة الطائفيّة والمذهبيّة في سوريا خلال نظام الأسد، بالإدّعاء انه نظام علماني لا يفرّق بين الطوائف والمذاهب، وعُيِّرَ بالطائفي واللاوطني كل من تكلّم عن حساسيات طائفيّة أو مذهبيّة أو من أشار الى التمييز بين المجموعات الدينيّة.
الثورة السورية وما تلاها من حرب أهليّة أظهرت الى العلن هذه الحساسيات وهذا التمييز. وبعد سقوط نظام الأسد على يد “هيئة تحرير الشام” سادت أجواء “وطنيّة” لا طائفيّة ولا مذهبيّة، رغم بعض الإنتهاكات المتفرّقة بحق بعض الأقليات الدينيّة. لكن سرعان ما انهارت كل هذه الدعاية “الوطنيّة”، مع اندلاع أحداث الساحل السوري وما رافقها من مجازر بحق المواطنين من الطائفة العلويّة. وسبق ذلك وتلاه بروز مخاوف درزيّة وكرديّة ومسيحيّة من الحكم الجديد، الذي يمثّل اتجاهاً أصولياً في الإسلام السياسي السني، المعروف بارتكابه مجازر بحق الطوائف والمذاهب الأخرى، حتى بحق مواطنين سنّة من اتّجاهات سياسيّة أخرى. وقد جاء “الإعلان الدستوري” ليعزّز هذه المخاوف من خلال مواده الصريحة التي تنص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع وعلى ضرورة ان يكون رئيس الجمهوريّة مسلماً، مع الحرص على إعطائه صلاحيات إستثنائيّة خلال فترة الخمس سنوات الانتقاليّة، من مثل تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، كما تعيين اللجنة التي ستساهم في اختيار الثلثين المتبقيين.
صُدم معارضون سابقون لنظام الأسد بالمجازر التي وقعت، وبعضهم ينتمي الى الاتّجاهات العلمانيّة، ومن بينهم فاروق مردم بك، الذي قال بصراحة تامة وبدون أي التباس: “لنعترف ونحن ندفن قتلانا، بأن الطائفيّة متجذّرة في بلادنا، تغفو حينًا ثم تستيقظ كلّما سنحت لها الفرصة متعطّشة للدماء. ظننّا ان شعاراتنا القوميّة العربيّة كافية لاجتثاثها، ونراوغها اليوم بالكلام على الوطنيّة السوريّة كما لو أن وطننا لم تمزّقه الأحقاد الطائفيّة التي راكمها الاستبداد الأسدي وزادها حدّة تغوّل الحركات الجهاديّة. لا بدّ للاعتراف بواقعنا على حقيقته لا كما نتصوره…”.
التطوّرات السوريّة استدعت أيضاً مواقف عراقيّة ولبنانيّة. في العراق عاد التجاذب السني – الشيعي حول حدود الأقاليم، ومن يسيطر على المياه ومن يسيطر على النفط. وفي لبنان الموقف الأبرز والأوضح کان للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي “حذّر من تداعيات المذابح التي تحصل في سوريا على المنطقة بأكملها ولبنان خصوصا”، مناشداً ضرورة “ضبط الامور قبل ان تذر الفتنة الكبرى بقرنها”. وتعبير “الفتنة الكبرى”، هو استرجاع لوصف الفتنة الذي اندلعت بين السنة والشيعة منذ ١٤٠٠ السنة.
هذا الصدى المذهبي العراقي واللبناني على المجازر المذهبيّة في سوريا، يُضاف اليه تعاظم المخاوف الدرزيّة في السويداء من الاندماج تحت حكم السلطة السوريّة الجديدة .
مع ذلك يستمر كثيرون في البلدان الثلاثة بإنكار الحساسيات المذهبيّة التي تلامس الكراهيّة المتبادلة. ويمكننا تقسيم مجموعة الإنكار هذه إلى أربعة فئات على الأقل:
– فئة رجالات السلطة والمستفيدين منها، الذين يريدون إضفاء شرعيّة دستوريّة وطنيّة على حكمهم الفئوي التسلطي. الأسد لجأ الى غطاء العلمانية والشرع يلجأ الى غطاء الاسلام الذي يجمع بين المذاهب الاسلاميّة. لكنّ حجّته أضعف من حجّة الأسد فهي لا تشمل المسيحيين.
– فئة “القوميين العرب” بمختلف تسمياتهم، والذين لا يرون في سوريا الا مواطنين عرباً بغض النظر عن اديانهم ومذاهبهم. وهم والأسد والشرع لا يعيرون اهتماماً للأقليّة الكرديّة، كمكوّن غير عربي. ولطالما ارتبط الفكر القومي بمصالح حزبية ضيّقة متمسكة بالسلطة.
-فئة “اليساريين” الذين لا تسمح لهم عقيدتهم إلاّ برصد الطبقات في المجتمع، لدرجة أن اليسار اللبناني في حرب ١٩٧٥، كان مضطرًّا لتحويل الطوائف والمذاهب إلى طبقات، من خلال مقولة “الطائفة-الطبقة”، حتى يستطيع أن يتقبّل فكرة وجود الطوائف والمذاهب وتأثيرها في العلاقات بين المواطنين، وحتى يبرّر بالتالي مشاركته في حرب طائفيّة.
– الفئات الثلاث أعلاه تفسّر النزاعات الطائفيّة والمذهبيّة- هذا إن إعترفت بها- بالتدخّلات الخارجيّة ذات الأطماع الاستعماريّة، أو بالأنظمة السياسيّة القائمة على أساس طائفي. على عكس الفئة الرابعة التي هي فئة “المؤمنين” العاديين، فهي تعيش تناقضاً في مشاعرها. لديها من جهة نزعات نفسيّة-إجتماعيّة متأثرة بالواقع الطائفي والمذهبي المعاش وبذاكرة جماعية متداولة تغذي الأفكار المسبقة والكراهية تجاه الآخر المختلف؛ ومن جهة إخرى نزعة دينيّة- اخلاقيّة تدعوها إلى التسامح وقبول الآخر. وينتج عن هذا التناقض إحساس بالذنب وكبتًا للمشاعر العدائيّة ورفضاً للاعتراف بها.
الفكر القومي يختزل العوامل المؤثرة بالسلوك الانساني بعامل الانتماء القومي، والفكر الماركسي- الارثوذكسي يختزلها بعامل الانتماء الطبقي، والاثنان يهملان العوامل المجتمعية والثقافية والدينية التي تبلور السلوك المذهبي- الطائفي. العوامل جميعها لها دورها دون ادنى شك، لكن كما يبدو من التجربة التاريخية، لا تزال العلاقات المذهبية والطائفية أقوى وافعل من العلاقات القومية والطبقية في تشكيل الوعي الفردي، في كافة دول المشرق العربي.
لكن من الضروري الإشارة الى ان مصدر الكراهيّة، قد يكون عدائيّة كامنة تولّدها الحياة اليوميّة في العائلة والمدرسة والعمل والمجتمع ولا علاقة لها بالمواقف الطائفيّة، لكنّها تجد في هذه المواقف متنفساً جماعيًّا لها، بحكم انتشارها.
لا يمكن معالجة النزاعات المذهبيّة والطائفيّة من خلال انكارها، والتجارب اللبنانيّة والسوريّة والعراقيّة أسطع برهان على ذلك: فلا طمسها من قبل نظامي البعث السوري والعراقي، ولا الاعتراف بها بخجل من خلال النظام اللبناني، أدّيا إلى تجنّب المجازر الدورية. قالها لنا ابو تمام منذ زمن العباسيين، ولو لأغراض مختلفة: “السيف أصدق انباءً من الكتب، في حده الحدّ بين الجد واللعب”. فلنتوقف عن اللعب بمصائر شعوبنا ولنصدِّق السيف قبل أن يقضي علينا جميعًا.
لم يجرِ اللجوء الى القانون تاريخياً لتنظيم المحبّة بل للجم الكراهية بين البشر. فلا بأس إن اعترفنا نحن أيضًا بحاجتنا إلى قانون “ينظّم” هذه الكراهية ويمنعها من التحوّل إلى عنف مطلق.
يجب للاسراع في اقرار قانون لإنشاء مجلس الشيوخ وقانون اللامركزيّة الموسّعة. هكذا تتفادى البلاد الصدمات الكبيرة التي لم تعد تحتملها، وتأخذ المبادرة بدل ان تكون سياساتها كما حصل في السابق، ردود فعل على التطوّرات الخارجيّة التي لا تأتي في العادة لصالحها.
إن حصر السلاح بيد الدولة هو شرط اشتغال مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية، مما يسمح لمختلف فئات الشعب ان تعيش بطمأنينة وسلام. وعلى عكس ما يعتقد البعض، لم يحصل حصر السلاح بيد الدولة بعد نشوئها تاريخياً في العالم، بل كان شرطاً لوجودها، بعد أن توافقت الفئات المتقاتلة في حينه على العيش معاً بسلام.
النهار العربي
——————————
بين الطائفية والمحبّة… شهادة رعب وامتنان من الساحل السوري/ إبراهيم العلي
الجمعة 21 مارس 2025
يقال إنّ “المصائب تكشف معدن البشر”. آمنت شخصياً بصحة المقولة، بعد الأحداث الدامية التي حدثت في الساحل السوري. انقسم الشارع قسمين بين مهلل ومستهجن، ومدين ومبرر، وشامت ومكلوم، وإنساني وطائفي، وبين من أراد وقف المجازر والاقتصاص من القاتلين، ومن كان همّه فقط تبرئة الأمن العام من القتل دون تحميله مسؤولية عدم القدرة على حماية المدنيين العُزّل.
الدعتور تشعل شرارة الأحداث
يوم الثلاثاء الرابع من آذار/ مارس الجاري، استيقظت صباحاً وتفقدت أغراضي وجمعت مستلزماتي في حقيبة السفر، وسافرت من قريتي في ريف طرطوس إلى السكن الجامعي في اللاذقية، حيث كان عليّ أن أقضي نحو خمسة أيام لأقدّم امتحانَين وأعود. اخترت البقاء في السكن توفيراً للجهد ولأجور النقل الباهظة. وصلت إلى السكن الجامعي عند الساعة التاسعة، وبدأت بمراجعة الامتحان الذي كان مقرراً عند الساعة الواحدة ظهراً. عند الـ12 وربع، اتصل بي صديقي ليقول لي: “الامتحان تأجّل بسبب الأحداث في الدعتور”. لاقى القرار استياء الطلاب، لكننا سلّمنا أمرنا، وقلنا المهم السلامة، ولم نكن نعرف أنها البداية.
بدأت تتصاعد الأحداث في الدعتور، وتتعدد الروايات وتتضارب. وبدأ أقاربي ومعارفي يتصلون بي لأخبرهم عن الأحداث في هناك، فأقول لهم: “والله ما بعرف متلي متلكم عم إسمع من الفيسبوك”. لم أقف عند أحداث الدعتور، بل ظننت أنها عابرة فقد اعتدنا وبكل أسف على “الحالات الفردية” بين الحين والآخر.
مرّ يوم الأربعاء بسلام، لتبدأ الأنباء صباح يوم الخميس، بالوصول إلينا عن وجود إشكالية في ريف جبلة. أيضاً لم نلقِ بالاً للأمر، وأكملت دراستي وذهبت إلى سريري لآخذ قيلولة الظهر. بعد ساعة من النوم، استيقظت وزميلي على صوت طيّارة تتجه نحو جبلة مع أصوات القصف، وبدأ حينها مسلسل الرعب.
تصفحت وسائل التواصل الاجتماعي لأفهم ما يجري. أغلب الأخبار تقول إنّ “فلول النظام السابق” اعتدت على حاجز للأمن العام، وبدأت بعدها حملة موسعة من قبل “الأمن العام” للردّ على الهجوم، لتشتعل حينها الحرب وسط تقدّم ملحوظ “للفلول”، ما دعا القيادة في سوريا إلى الاستعانة بالفصائل المتشددة التي مارست عنوةً أقذر أنواع الإبادة والتطهير بحق المدنيين العُزّل العلويين في مختلف مدن طرطوس واللاذقية. عشنا أيام الخميس والجمعة والسبت في السكن الجامعي، رعباً لا يوصف بسبب أصوات الاشتباكات التي لم تهدأ وأخبار التطهير العرقي.
لا كهرباء ولا ماء ولا خبز
أصبحت مشاهد المجازر يوميةً. لكن بالإضافة إلى هذه المشاهد المؤسفة التي كنا نتابعها، أصبح هناك واقع معيشي صعب في السكن الجامعي؛ انقطعت الكهرباء عن السكن بالكامل، وتبع ذلك انقطاع الماء، بالإضافة إلى توقف أغلب الأفران عن العمل، ما خلق أزمة خبز خانقةً، وأصبح واقع السكن مختلفاً تماماً عن ذي قبل.
كنا نركض في السكن الجامعي وراء أي خبر، وبحثاً عن مكان لشحن الهواتف أو لتعبئة المياه أو لتوزيع الخبز، بعد أن كان هذا كله متوافراً.
يشيع خبر مفاده أنّ سيارة الخبز وصلت إلى السكن، فنرى جحافل الطلاب تتجه نحو المكان لنجد طابوراً طويلاً. المحظوظ منا أحياناً يرجع برغيفين، أما الباقي فيرجعون بخفيّ حُنين. الكهرباء لم تأتِ منذ ثلاثة أيام، فاضطررنا إلى الطبخ وتسخين المياه على الحطب، وهو ما أصبح ظاهرةً منتشرةً بعد أن كان ممنوعاً. أما طابور المياه، فحدّث ولا حرج؛ لا يوجد سوى مكان واحد فيه صنبور ينزّ بحبل رفيع، ماءً.
أصبح التعب النفسي يفوق التعب الجسدي، فالطلاب قلقون على أهاليهم. في الأيام الأولى، كنا نسمع صوت القصف الرصاص ونقرأ ما يحدث على فيسبوك، تماماً مثل غيرنا. كان الخوف علينا نحن الطلاب في السكن الجامعي، لكن ما إن تصاعدت الأحداث في ريف طرطوس، انعكست الآية وأصبحنا نحن من نخاف على أهالينا ونودّ لو بإمكاننا أن نأتي بهم إلى السكن الجامعي.
الطائفية مقابل المحبّة
أتصفح فيسبوك، وأرى المجازر التي تحصل من دون رقيب أو حسيب، بحجة الفلول والفصائل المنفلتة. يصيبني القرف من كل من يشمت بما يحصل أو يبرره. يقول أحدهم: “وين كنتم لما كان ينزت علينا براميل”، أو “ليش ما كنتم تدينوا جرائم الأسد لما أباد السنّة”. وكأنّ هؤلاء كانوا في عالم آخر. وكأنّ رفاهية الإدانة كانت متوافرةً لدينا ولديهم، أو كأنّهم هم الذين ملأوا الدنيا بالإدانات حين كانوا يعيشون في مناطق سيطرة نظام الأسد. كلنا كنّا رهائن بيد الأسد، ومن جميع الطوائف، ومن يرفع صوته يُخفَ. فحين تقول: “وينكم لما كان الأسد يضرب براميل”، تبدو كأنّك تقول: “الغايب يرفع إيدو”.
المؤسف أنّ هناك أناساً أكلنا وشربنا معهم طوال الفترة الماضية، كأخوة آمنين مأمّنين على بعضنا البعض، لكن فجأةً تتفاجأ بكمية الطائفية عند بعضهم. يضع صديق لي حالةً على فيسبوك، يقول فيها: “طالما لم تحترموا أكثريتنا لن نحترم أقلّيتكم”. أما الآخر، فيكتب: “كنتم أقليات وأصبحتم نوادر”. وكأنّ اعتراض هؤلاء على بشار الأسد، كان بدافع أن يحلّوا محله، فقط ليمارسوا الوحشية نفسها.
تفاجأت بكمية الطائفية، لكن تفاجأت أكثر بكمية المحبة من أصدقائي من الطوائف الأخرى. يتصل بي عشرات الأصدقاء يومياً، ممن تربطني بهم علاقة قوية أو عادية، ليطمئنوا عليّ. يتواصل معي صديقي محمد -شقيقه شهيد قُتل تحت التعذيب في معتقلات الأسدـ من مدينة زاكية التي تعرضت لأقسى أنواع الوحشية من نظام الأسد، ويقول لي: “شو ما احتجت قلي، واذا حسّيتوا ما في أمان بيتي بالشام مفتوح إلكم”. صديقي محمد، تعرّض لشتى أنواع القهر أيام الأسد، لكن الإنسانية والمحبة متأصلتان فيه، ولم تجعلاه يتمنى أن يحصل لغيره ما حصل معه. محمد مثال عن الثائر المنتصر الذي انتصر على كل محاولات نظام الأسد لتشويه إنسانية السوريين. محمد مثال، وغيره كثر ممن تعاطفوا معي ومع جميع أهالي الساحل. هؤلاء هم من يعرفون أنّ الإنسانية لا تتجزأ، وأن لا وطن ولا ثورة بلا إنسانية.
الشيء الجميل الآخر بين هذه المصائب كلها، حالة التعاضد والتعاون التي شهدتها في السكن الجامعي في اللاذقية. الطلاب من مختلف الأطياف والمحافظات يواسون بعضهم، ويقدّم كل منهم المعونة والمساعدة برغم الشحّ في كل شيء، ولو كان ذلك باقتسام رغيف الخبز الوحيد بينهم، ناهيك عن الكثير من المبادرات مثل توزيع خبز وسلل غذائية مجاناً من قبل فرق تطوعية. أعتقد أنّ حالة السكن الجامعي هذه تمثّل سوريا التي نريدها، سوريا اليد الواحدة، سوريا الضمير الحي.
عدت إلى منزلي مع باصات أمّنها مشكوراً المجلس الشيعي الاسماعيلي، مجاناً وللجميع. عدت باستنتاج تةصلت إليه من خلال متابعتي للأحداث في سوريا على مدى 14 عاماً وحتى اليوم: ليس كل معارض لنظام الأسد ثورياً، وليس كل داعم للسلطة الحالية ثورياً، هناك أمر يجب إيضاحه: السوريون ليسوا معارضةً وموالاةً أبداً. السوريون قسمان، قسم إنساني وقسم طائفي، القسم الطائفي يضمّ من كان يكره الأسد فقط لأنه علويّ، ومن كان يحبّ الأسد أيضاً فقط لأنه علويّ، ومن يحبّ الشرع فقط لأنه سنّي، ومن يكره الشرع أيضاً فقط لأنه سنّي. أما القسم الإنساني، فمكوّن ممن كان ضد الأسد لأنه مجرم، ومن كان مع الأسد مخدوعاً به أو على سبيل أنه “أحسن السيئين”، ومن هو مع الشرع لأنّه “محرر سوريا” وسوف يقودها إلى برّ الأمان، ومن هو ضد الشرع باعتباره متطرفاً ذا خلفية جهادية.
رصيف 22
————————-
بيان
استغلت فلول نظام بشار الأسد عيوب وثغرات العملية السياسية الهادفة لتوليد دولة سورية جديدة من أجل أن تضرب ضربتها في عملية التمرد العسكري، التي قامت بها عند مغرب يوم 6 آذار، والتي ارتكبت من خلالها مجازر سقط من جرائها مئات الضحايا من قوات الأمن العام أثناء تناولهم طعام الافطار الرمضاني، ولم يكن بعيداً عن قصدها أن تُولِد تلك المجازر مجازر أخرى على أساس الهوية الطائفية، تقوم بها فصائل تحمل نزعات انتقامية ، وذلك بقصد من تلك الفلول لإنشاء شرخ وطني عميق يمنع الولادة السورية الجديدة.
فالسوريون قد غمرهم التفاؤل عندما قالت إدارة السلطة الجديدة مابعد سقوط حكم بشار الأسد أنها تخطط لعقد مؤتمر وطني عام تنبثق عنه خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وسلطة تنفيذية وثانية تشريعية وإعلان دستوري ولجنة لصياغة الدستور، ولكنهم فوجئوا بعد خمسين يوماً بانعقاد مؤتمر لفصائل عسكرية حدُد ملامح المرحلة الانتقالية ، بما فيها السلطات التنفيذية والتشريعية وآلية إنشاء الإعلان الدستوري، من دون مشاركة وطنية عامة تشمل القوى السياسية والاجتماعية وأخرى عسكرية غابت ولم تدع لذلك المؤتمر، ثم تمت الدعوة إلى مؤتمر حوار يحمل صفة استشارية تمت دعوة أعضائه بصفتهم الفردية وبعضهم منتسب لأحزاب وقوى سياسية، في إشارة من السلطة الجديدة على أنها تتعامل مع السوريين كأفراد فيما كان السوريون ، طوال قرن من الزمن ، رواداً للمنطقة في تأسيس الأحزاب وانشاء الأفكار والتيارات السياسية.
وهذا قد جعل السوريين في حالة انقسام تجاه ما جرى منذ يوم 29 كانون الثاني بعد أن حصل إجماع وطني عام ما بعد سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول، وأصابهم القلق من أن هذا يخالف ماقاله المجتمع الدولي- الإقليمي عندما طرح مطلب “الانتقال السوري الجامع الشامل”، وهو ما كرره بيان مجلس الأمن الدولي الأخير في 14 آذار عندما دعا إلى قيام ” عملية انتقال سياسي شاملة ، يقودها ويملكها السوريون و تيسرها الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ المرسومة في القرار 2254″، وهو بيان أتى في اليوم التالي لصدور (الإعلان الدستوري)، الذي يكرس سلطة فردية ويخضع السلطتين التشريعية والقضائية لرأس السلطة التنفيذية ، وهو يخالف كل الاعلانات الدستورية المؤقتة بعد سقوط الحكم الديكتاتوري، كما في الاعلان الدستوري المصري في 30 مارس 2011 بعد سقوط حكم حسني مبارك عندما حددت مدته بخمسة عشر شهراً وليس بخمس سنوات كما في الإعلان السوري، ولم يعط المجلس العسكري برئاسة الفريق حسين طنطاوي صلاحيات مماثلة ، وكانت حيادية الدولة فيه أوسع تجاه المكونات الاجتماعية والسياسية.
إننا نطالب بمراجعة عملية المسار السياسي الانتقالي السورية ، والبدء بمشاورات حثيثة من أجل أن تنظم السلطة الجديدة، بالتشاور مع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية، مؤتمراً وطنياً عاماً تنبثق عنه خريطة طريق المرحلة الانتقالية بكل محتوياتها وتفرعاتها ،تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات ، وأن يكون اختيار المؤسسات التشريعية والقضائية والمحكمة الدستورية العليا من المؤتمر الوطني العام وليس من لجان معينة تعييناً، على أن يكون هذا الانتقال محكوماً بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات لجميع السوريين ومبدأ الحريات الشاملة غير المقيدة في تأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية تأسيس وسائل الاعلام المختلفة وحرية التظاهر والاضراب، وذلك من أجل أن يقود السوريون، المتساوون والأحرار، هذه العملية الانتقالية .
كما نطالب بإدانة وطنية عامة لمجازر 6 آذار التي ارتكبتها فلول النظام البائد بحق أفراد الأمن العام وجلبهم للمحاكم والاقتصاص القانوني منهم، و بإدانة وطنية عامة للمجازر التي ارتكبت في أيام 7-8-9 آذار بحق مواطنين مدنيين على الهوية الطائفية والتحقيق وجلب الجناة للمحاكم العلنية والاقتصاص القانوني منهم والتعويض لأهالي الضحايا وجبر الخاطر لهم ، من أجل أن يكون شهر آذار 2025 بداية صفحة جديدة تطوى من خلالها صفحات المجازر التي بدأت في عهد حافظ الأسد و استمرت في عهد ابنه.
عاش الشعب السوري…
17 آذار 2025
المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية
——————–
=====================
===========================
واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 21 أذار 2025
تحديث 21 أذار 2025
——————————-
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع
—————————–
سوريا… احتدام التنافس بين أجندات الخارج والداخل/ إبراهيم حميدي
ترمب يتوقع التقسيم وإسرائيل تريد “فيدرالية” وإيران تدفع إلى “التشظي”… والدول العربية تريد الاستقرار
19 مارس 2025
الرئيس دونالد ترمب قال في جلسة مغلقة، إن سوريا “ماضية إلى التقسيم لثلاث مناطق”. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث علنا عن “حماية الدروز”، وروج آخرون في حكومته لسيناريو “الفيدرالية”. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد دعم “وحدة سوريا” و”محاربة الإرهاب” ومنع قيام كيان كردي.
إيران، من جهتها، لم تقبل الهزيمة الاستراتيجية في سوريا. امتصت الصدمة وقررت التحرك فيها عبر “ثلاث جبهات”، فيما قبلت روسيا بتقليل خسائرها والبحث مع دمشق عن علاقات جديدة تتضمن استمرار وجودها العسكري ونفوذها في البلاد والإقليم.
أما الدول العربية والأوروبية، فقررت الانخراط مع الإدارة السورية الجديدة، لأن “دعمها أقل كلفة من أي بديل آخر”، وهي تريد الاستثمار في المكاسب الجيوسياسية، المتعلقة بخسارة إيران وروسيا، لأن أمن سوريا يتعلق بأمنها واستقرار الإقليم.
هذه خلاصة تقديرات ومعلومات من مسؤولين غربيين تحدثوا إلى “المجلة” خلال الأيام الماضية.
أميركا: التقسيم
في الأيام الأخيرة لإدارة جو بايدن، فتحت بابا للحوار مع الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتقت المسؤولة في الخارجية باربرا ليف، رئيس الإدارة أحمد الشرع في دمشق، وواصلت اتصالات غير معلنة قام بها دبلوماسيون أميركيون مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، كما خففت بعض العقوبات عن قطاعات سورية لمدة ستة أشهر.
منذ مجي إدارة دونالد ترمب، تشير المعلومات إلى وجود اتجاهين:
الأول، يرفض الانخراط مطلقا مع دمشق ويستند في موقفه إلى بُعد أيديولوجي يتعلق بـ”القاعدة”، أو تجارب شخصية تخص حرب العراق وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 أو بسبب علاقة شخصية مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مثل مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد. كما يرفض أصحاب هذا الرأي العمل مع الجيش السوري الجديد لمحاربة “داعش” ضمن التحالف الدولي وقيادة عملية “العزم الصلب”.
الثاني، مستعد لـ”انخراط مشروط” وفق مقاربة “خطوة مقابل خطوة”، عبر إقدام دمشق على سلسلة من خطوات تشمل: تشكيل حكومة جامعة، تشكيل جيش مهني حرفي، إبعاد المقاتلين الأجانب، تدمير برنامج السلاح الكيماوي والتدمير الشامل، محاربة “داعش”، التمسك بإبعاد إيران خارج سوريا، قطع طريق الإمداد إلى “حزب الله”، عدم الموافقة على استمرار وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين.
في المقابل، تعرض واشنطن استعدادها لخطوات تشمل تخفيف العقوبات على قطاعات محددة في شكل تصاعدي وصولا إلى رفع كامل للعقوبات و”قانون قيصر” في نهاية المطاف بعد حوالي أربع سنوات، علما أن قائمة العقوبات الأميركية تشمل “قانون قيصر” و”قانون محاسبة سوريا” و”دعم الإرهاب”، ويعود بعضها إلى عام 1979، إضافة إلى عقوبات فردية ضد مسؤولين في النظام السابق وشخصيات حالية أخرى.
سوريا ليست أولوية على أجندة ترمب. وتجري حاليا مراجعة داخل المؤسسات الأميركية وصولا إلى سياسة موحدة إزاء سوريا. ونُقل عن ترمب قوله في اجتماع خاص إن سوريا ستقسم إلى ثلاث مناطق تابعة لقوى خارجية مثل إسرائيل وتركيا وغيرهما، وإنه لا بد من محاربة “الإرهاب”، مع تلميح إلى إمكانية الانسحاب من شمال شرقي سوريا، الأمر الذي دفع وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى إعداد خطط للانسحاب في ستة أشهر، ودعمها بقوة لقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي للوصول إلى حل تفاوضي مع الرئيس أحمد الشرع خلال ذلك.
إسرائيل: فيدرالية
يراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التأثير على ترمب وفريقه، بحيث تكون حسابات تل أبيب ذات أولوية في البيت الأبيض الذي لا يدرج سوريا ضمن أولوياته في الشرق الأوسط. بالفعل، جرت مناقشات بين أجهزة إسرائيلية وأخرى أميركية حول هذا الملف، مع ترجيح رأي تل أبيب في شؤون جارتها.
نتنياهو يعتبر سوريا أولوية له هي والأمن القومي وإبعاد ايران. فالجيش الإسرائيلي قام بمجرد سقوط الأسد بتدمير جميع الأصول العسكرية الاستراتيجية السورية، البرية والجوية والبحرية والبرامج العلمية والصاروخية. كما احتل المنطقة العازلة في الجولان بموجب اتفاق “فك الاشتباك” لعام 1974. وسيطر على قمة جبل الشيخ ومنابع المياه في المنطقة. وشن سلسلة غارات في جنوب سوريا ووسطها لمنع بناء أصول استراتيجية دفاعية سورية.
إضافة إلى ذلك، تتخذ إسرائيل موقفا عدائيا ضد الحكم السوري الجديد، وهي تدفع باتجاه إقامة “فيدرالية” أو “لامركزية واسعة” في سوريا، تشمل إقليما جنوبيا يتضمن السويداء ودرعا، وشرقيا يشمل “قوات سوريا الديمقراطية”، وغربيا يتضمن إقليما علويا، بحيث يبقى الإقليم العربي-السني الأكبر معزولا عن جواره وفضاءات المياه الدافئة.
جرت اتصالات سرية حول هذه الأمور في واشنطن وعواصم إقليمية. ويدفع نتنياهو بقوة لإقناع ترمب وفريقه بهذا التصور، الذي هو موضع قلق عربي وتركي ومواكبة إيرانية غير مباشرة ومتابعة روسية، كما هو محل مواكبة أوروبية مع ترجيح للمقاربة البريطانية.
روسيا: تقليل الخسائر
عندما أدرك الرئيس فلاديمير بوتين قرب نهاية بشار الأسد الذي تمرد مرات عدة على طلباته- وكان آخرها رفضه لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بناء على مبادرة الكرملين- رتب مع نظيره التركي الانخراط في الأيام الأخيرة من نظام الأسد لتقليل الخسائر الروسية الاستراتيجية وتجنيب دمشق والموالين للنظام الخراب والانتقام.
بالفعل جرى الانتقال بأقل كلفة للمدن والبشر والموالين للنظام، ولم تتعرض القاعدتان الروسيتان، في حميميم وطرطوس، لأي هجمات من النظام السوري الجديد. كما صدرت تصريحات من المسؤولين السوريين الجدد تتحدث عن العلاقة القديمة مع روسيا واحترام مصالحها باعتبارها دولة كبرى.
زار ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي دمشق والتقى الرئيس الشرع الذي تلقى اتصالا معلنا من بوتين وآخر غير معلن. تتناول المحادثات السورية–الروسية نقاطا عدة: التزود بالسلاح الروسي، تسلم بشار الأسد وكبار المسؤولين المتهمين بجرائم حرب، مستقبل القاعدتين الروسيتين، المساهمة في إعمار سوريا، تقديم المساعدات والأموال السورية المطبوعة تعويضا عن مساهمة روسيا في قمع الشعب السوري، الديون الروسية لسوريا.
بوتين أبلغ دمشق رسالة واضحة بأنه لن يسلم الأسد إلى دمشق، لأنه “قال كلمته وقدم له لجوءا إنسانيا”، كما أنه لم يقبل فكرة أن “ينتحر الأسد على الطريقة الروسية”، لكن موسكو أبدت انفتاحا لتقديم السلاح والمساهمة في الإعمار وسحب قواتها “فورا إذا أرادت دمشق”. كما أبدت دمشق انفتاحا لبحث وجود عسكري روسي في سوريا. والمفاوضات جارية وتتناول هذه البنود والمقايضات.
في هذا السياق، حصل تطوران: الأول، أن تل أبيب سعت لدى واشنطن لتأييد استمرار الوجود الروسي لـ”موازنة النفوذ التركي” في سوريا. والثاني، تمرد فلول النظام السوري في الساحل، حيث اتخذت موسكو موقفا يسمح لها باستخدام هذا التمرد ورقة ضغط على دمشق وورقة تسمح لها بترك الخيارات مفتوحة في حال أقيم إقليم علوي.
إيران: التشظي
لم تقبل طهران الواقع الجديد بفقدان سوريا بعد لبنان، فهي خسرت طريق الإمداد إلى “حزب الله”، والحديقة الخلفية للعراق، وأداة الضغط على إسرائيل عبر جبهتي لبنان وسوريا. كل المؤشرات تشير إلى تفضيل إيران خيار “التشظي السوري” والرهان على الوقت، لاستعادة موطئ قدم في سوريا. عليه، بدأت في الفترة الأخيرة بعد اجتماعات سرية عدة تحريك أوراقها لفتح ثلاث جبهات:
الأولى، استعادة علاقات مع مسؤولين في النظام السوري السابق كان بينهم العميد غياث دالا، الذي كان يقود “قوات الغيث” في “الفرقة الرابعة” بقيادة اللواء ماهر، شقيق بشار الأسد، وكان ضابط الارتباط مع “الحرس” الإيراني و”حزب الله”. ماهر الأسد نفسه هرب مع قادة ميليشيات تابعة لإيران في 8 ديسمبر/كانون الأول إلى العراق، وقيل إنه انتقل إلى السليمانية في كردستان العراق. ومن غير المؤكد مكان وجوده الحالي. كانت أيادي إيران واضحة في تمرد الساحل الأخير، بالدعاية والتدريب والمعلومات.
الثانية، الضغط على “الحشد الشعبي” العراقي للتحرك نحو الحدود السورية. وإيران تريد تعزيز وجودها في العراق بعد خسارات “الهلال” في بلاد الشام، وتريد استخدامه في الملعب السوري. أيضا، يجري تداول سيناريو عودة “داعش” للنشاط في الأنبار وغربي العراق والتوغل نحو البادية السورية.
الثالثة، الضغط على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وتحريك عشائر عربية شرق الفرات، للتنسيق والعمل العسكري ضد الإدارة السورية الجديدة. قائد “قسد” نفى ذلك في حديثه إلى “المجلة”. وقال: “لن يكون هناك مستقبل لعلاقات مع إيران. ونحن حاليا نركز على أن نكون جزءا من الإدارة الجديدة وجزءا من المحادثات السياسية لا أن نكون معارضة كما يتهمنا البعض”. كما وقع اتفاق مبادئ مع الرئيس الشرع في دمشق يوم 10 مارس/آذار بعد جهود أميركية وفرنسية مكثفة.
تركيا: مع الوحدة ضد كيان كردي
لم يكن أردوغان مرتاحا كثيرا لاتفاق الشرع-عبدي. الاتفاق كان موجودا على طاولتيهما منذ لقائهما في 29 ديسمبر، لكن تمرد الساحل والانتهاكات فيه من جهة، وحديث الأميركيين السري عن احتمال الانسحاب بعد ستة أشهر من جهة ثانية، وتفاهم زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبدالله أوجلان مع أنقرة من جهة ثالثة، دفعت الشرع وعبدي لتلبية جهود أميركية-فرنسية، وتوقيع اتفاق يحتاج تنفيذه إلى الكثير من التفاوض وخريطة طريق، هي في قبضة مساعديهما. مظلوم حق نجاحا بأنه “فتح باباً رئاسياً لمناقشة حقوق الأكراد لأول مرة في التاريخ”. والشرع، فتح باباً سورياً لحياكة الخريطة السورية بعد أكثر من عقد من التآكل.
تركيا تدفع إلى تنفيذ مبادئ الشرع-عبدي، وهي: منع وجود “الإدارة الذاتية” وأي كيان كردي، وانضواء شمال شرقي سوريا ضمن سوريا الموحدة، وتفكيك البنية العسكرية الثقيلة لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية، وطرد قادة “حزب العمال الكردستاني” الموجودين في قيادة “الوحدات”.
وتسعى تركيا للإفادة من علاقتها مع “هيئة تحرير الشام” والشرع للدفع باتجاه تعزيز نفوذها في سوريا والإقليم في النواحي التجارية والعسكرية والسياسية والجيوسياسية. فسوريا تاريخيا بوابة تركيا إلى العالم العربي. لكن هذا النفوذ هو مصدر قلق لدول أخرى بينها دول عربية فاعلة.
الدول العربية: استقرار سوريا ووحدتها
منذ سقوط الأسد، بادرت دول عربية كبرى لدعم النظام الجديد وفتح صفحة جديدة معه، لأسباب عدة، بينها: البناء على الخسارة الاستراتيجية الأكبر لإيران منذ 1979. تخفيف اعتماد النظام السوري الجديد على تركيا. الحوار والانخراط والدعم لسوريا الجديدة وإعطائها الفرصة، لأن البديل سيئ جدا، والفوضى في سوريا مضرة والتقسيم خطير على الدول المجاورة والأمن الإقليمي العربي.
اكتشفت دول عربية حدود التحرك والدعم. لا يزال سيف العقوبات مسلطا. أميركا وافقت على تسهيل إمداد سوريا بالغاز لصالح توفير الكهرباء وسمحت بصفقة تتضمن مقايضة إعفاءات مقابل الوصول إلى السلاح الكيماوي السوري، لكنها لا تزال ترفض السماح بتحويلات مالية كبرى والانفتاح على النظام المصرفي السوري. هناك إصرار على ترك هامش الوقت لدمشق وتقديم النصيحة وليس الضغط والتحاور مع واشنطن ودول أوروبية لاعتماد أفضل الخيارات الواقعية حاليا في سوريا.
الأجندة السورية وجرس الإنذار
ما حصل في الساحل السوري بين 6 و10 مارس/آذار، سواء التمرد أو الانتهاكات الكبيرة، كان بمثابة جرس إنذار. فقد أظهر أهمية المفاجأة التي حصلت في 8 ديسمبر، إذ سقط نظام الأسد بعد 54 سنة من دون كلف دموية كبيرة بفضل التزام العناصر في “هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى بتعليمات القيادة العليا.
لكنه أظهر في الوقت نفسه، أسئلة حول سلسلة القيادة من فوق إلى أدنى، ومدى التزام المقاتلين أو الفصائل بالتعليمات، وطرح أسئلة في عواصم أوروبية عن “حماية الأقليات”، ودفع باريس إلى تأجيل توجيه دعوة لزيارات رفيعة لمسؤولين سوريين وعواصم أخرى لتجميد إعادة فتح سفاراتها لأسباب أمنية. إضافة إلى ذلك، كان بمثابة ناقوس خطر لما يمكن أن يحصل في حال عمت الفوضى. فتشظي سوريا يعني تطاير الشظايا والجهاديين في الإقليم وما وراءه.
برزت مشكلة تسريح عناصر الجيش والأمن والشرطة وموظفي القطاع العام، وتوفير الخدمات والكهرباء. فأصبح الملف الاقتصادي الاجتماعي أولوية للحكم الجديد. فالعقوبات لم ترفع والمساعدات الدولية تراجعت والتوقعات الشعبية زادت. قد يكون أحد الحلول طبع أموال جديدة، وتنفيذ هذا في موسكو. قد يكون الرمق في مساعدات عاجلة، لكنها قليلة طالما أنها عينية مرتبطة بالنظام المصرفي الغربي. ولا تزال الجالية السورية وحلفاء دمشق العرب والإقليميون، يعملون لدى واشنطن لرفع العقوبات وتخفيف معاناة الناس، لأنه دون ذلك، فإن تأثير رفع العقوبات الأوروبية والبريطانية والكندية سيكون محدودا جدا.
وأظهر المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل يوم 17 مارس/آذار، الدعم الأوروبي المستمر للسوريين، حيث أعلن عن تعهدات مالية بقيمة ستة مليارات دولار أميركي. فمنذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 37 مليار يورو من المساعدات داخل البلاد وفي المنطقة.
لكن الأهم أن المؤتمر أظهر، أن دعم الحكم السوري الجديد سيكون أقل كلفة من أي خيار آخر، بما في ذلك خيار عزله. وواصلت فرنسا جهودها لحشد المجتمع الدولي، تماشيا مع مؤتمر باريس في 13 فبراير/شباط، لإيجاد حلول دائمة وتوفير الاحتياجات الأساسية. كما جددت رسالتها إلى السلطات السورية بضرورة محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن العنف ضد الضحايا المدنيين في الأسابيع الأخيرة.
مقابل الأجندات الخارجية، هناك أجندة سوريا وخيوط سورية. وباعتبار ما حدث في الساحل كان جرس إنذار واختبارا كبيرا، فإن الشرع رد عليه بسلسلة خطوات برغماتية انفتاحية تمثلت في تشكيل لجنة تحقيق ولجنة للسلم الأهلي وإعلان دستوري. هناك انقسام حول هذه الخطوات. البعض قابله بالترحيب، فيما شكك آخرون فيها وطرحوا أسئلة عن ضرورة أن تكون الخطوات جامعة وأن تكون الخطوط مفتوحة في الاتجاهين بين المركز والأطراف.
أجندة دمشق هي رفض التقسيم ورفض الفيدرالية والعمل على بناء جيش وطني وحكومة ومؤسسات دولة وتعميم السلم الأهلي. واتفاق الشرع–عبدي، كان يعني في أحد جوانبه، إعطاء أولوية للأجندة الوطنية. هناك خطوات منتظرة ومتبادلة بين المركز وجهات الجنوب والشمال والغرب، لقطع الطريق على الأجندات الخارجية المتنافسة. وهناك أجندات خارجية متنافسة على مستقبل سوريا. عمليا، يحتدم الصراع بين أجندات الخارج وأجندة الداخل، ولكل أدواته وتحالفاته وإمكاناته ومواقيته.
المجلة
——————————-
سورية: مساعٍ لتأسيس مرجعية واحدة للأكراد لمفاوضة الإدارة الجديدة/ محمد أمين
20 مارس 2025
عُقدت، أمس الأربعاء، الجولة الأولى من اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة السورية في دمشق وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ومسؤولين أميركيين في الحسكة السورية، في محاولة للدفع نحو تسريع تطبيق الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي في 10 مارس/آذار الماضي. وذكر بيان لـ”قسد” أمس أن عبدي “اجتمع أمس مع اللجنة التي شكّلها الشرع لاستكمال الاتفاق بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية”، وأنه “جرى تداول للآراء خلال الاجتماع، وتمت مناقشة آلية عمل اللجان والتي من المقرر أن تبدأ العمل بشكل مشترك مع بداية شهر إبريل/ نيسان المقبل”. ولفت البيان إلى أن “الاجتماع تطرق للإعلان الدستوري والحاجة لعدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سورية وكتابة دستور”، و”توقف الاجتماع مطولاً على ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية”. وبحسب البيان، شارك في الاجتماع عضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة روهلات عفرين، إلى جانب رئيس اللجنة من جانب الإدارة السورية حسين سلامة، إضافة إلى أعضاء آخرين من الجانبين.
محاولة لتوحيد رؤية الأكراد في سورية
في موازاة ذلك، يحاول أكبر تشكيلين سياسيين في المشهد السياسي الكردي في سورية وهما المجلس الوطني الكردي، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ردم هوة الخلاف بينهما للتوصل إلى رؤية سياسية واحدة تفضي إلى تشكيل وفد واحد يحمل مطالب الشارع الكردي إلى دمشق للتفاوض مع الإدارة الجديدة. وعقد الطرفان أمس الأول الثلاثاء اجتماعاً في الحسكة أقصى الشمال الشرقي من سورية تحت إشراف مظلوم عبدي، وبرعاية أميركية تجسدت بحضور المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة شمال وشرق سورية سكوت بولز. وتشي التصريحات الرسمية التي أعقبت الاجتماع أن الطرفين بصدد ردم هوّة خلاف اتسعت خلال سنوات الأزمة السورية، من أجل توحيد الرؤى والتوصل إلى تفاهمات حقيقية تؤسس مرجعية سياسية واحدة للأكراد السوريين تمثّلهم في الاستحقاقات المهمة في مرحلة ما بعد بشار الأسد المخلوع.
ويبدو أن الاتفاق الذي أبرمه عبدي أخيراً مع الرئاسة السورية لدمج هذه القوات في المنظومة العسكرية للبلاد، وحسم مصير المناطق التي تقع تحت سيطرتها، دفع القوى السياسية الكردية إلى الجلوس على طاولة حوار يرقى إلى مستوى التفاوض من أجل تشكيل وفد واحد يمثل الأكراد السوريين. ويحمل اتفاق عبدي مع دمشق طابعاً عسكرياً أكثر من كونه اتفاقاً سياسياً، وهو يخص قوات “قسد” ذات الطابع الكردي، وتضم مكونات أخرى من عرب وأشوريين وسريان، لذا لا يُعتبر اتفاقاً سياسياً بين دمشق والقوى السياسية الكردية، على الرغم من أن “الاتحاد الديمقراطي” هو المسيطر على هذه القوات عن طريق ذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية). ومن المتوقع إعلان تشكيلة الوفد المشترك بين المجلس الوطني و”الاتحاد الديمقراطي” مطلع الأسبوع المقبل بعد الاحتفال بعيد النوروز، وهو عيد سنوي للأكراد في كل أنحاء العالم.
أكراد يتظاهرون في القامشلي رفضا للإعلان الدستوري، 18 مارس 2025 (العربي الجديد)
ولكن أحزاباً كردية استُبعدت من الحوار الجاري أبدت تحفظها على أي وفد يجري تشكيله ويكون مقتصراً على المجلس وحزب “الاتحاد”، ومنها الحزب اليساري الكردي في سورية، الذي أكد سكرتيره محمد موسى، في حديث مع “العربي الجديد”، أن حزبه ليس مسؤولاً “عما يتوصل إليه الطرفان من نتائج في اجتماعهما”. ويبدو أن المجلس الوطني اعتبر أحزاب “الإدارة الذاتية” تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يرأس هذه الإدارة، وهو ما دفع موسى إلى وصف ما يجري بأنه “مؤامرة” و”لعبة سيئة” من طرف المجلس.
ولطالما حالت الخلافات الجوهرية بين المجلس الوطني الكردي، الذي يضم العديد من الأحزاب، وبين الاتحاد الديمقراطي، دون توحيد الصف السياسي الكردي في سورية، على الرغم من كل المحاولات التي بُذلت على هذا الصعيد. ويتلقى المجلس دعماً سياسياً من قيادة إقليم كردستان العراق، بينما يُنظر إلى “الاتحاد الديمقراطي” على أنه نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني التركي والمصنف في خانة التنظيمات الإرهابية لدى العديد من دول العالم. عملياً، يعد “الاتحاد الديمقراطي” الطرف الأقوى في المعادلة الكردية في سورية كونه يملك جناحاً عسكرياً يسيطر على الجانب الأغنى بالثروات في سورية وهو ما بات يُعرف اصطلاحاً بـ”شرقي الفرات”. ولكن هذا الحزب يقع تحت وطأة التهديد خصوصاً من الجانب التركي والذي يتعامل مع المجلس على أنه الممثل الأكثر ثقة للأكراد السوريين.
اعتراضات على اتفاق الشرع وعبدي
ولم يرض الشارع الكردي الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي في مارس الحالي والذي اعترف بـ”المجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية”، وأكد “ضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية”، فهو لم يرق إلى مستوى تطلعات الأكراد في سورية. فالقوى السياسية الكردية على اختلاف مشاربها الفكرية، تكاد تجمع على مطالب بعينها تدفع من أجل تحقيقها خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها سورية، فهي تريد اعترافاً دستورياً بالشعب الكردي ولغته، وترى أن الأكراد هم القومية الثانية في البلاد، لذا تطالب بـ”اللامركزية” في الحكم ما يتيح للأكراد حكم أنفسهم في مناطق يشكلون غالبية سكانها.
وفي هذا الصدد، أوضح القيادي في المجلس الوطني الكردي شلال كدو، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الاتفاق “لم يحصل بعد بين المجلس والاتحاد الديمقراطي على تشكيل وفد سياسي واحد يحمل مطالب الشارع الكردي إلى دمشق”، مضيفاً: “لم نُوقّع أي اتفاقات بعد مع حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكن الرؤية الكردية لسورية المستقبل ربما ستقوم على أن تكون سورية دولة ديمقراطية لا مركزية برلمانية، تعددية”. وعن أبرز مطالب الأكراد السوريين، أوضح أن الأكراد “باعتقادي سوف يطالبون بالاعتراف بهم كثاني قومية في البلاد في الدستور، مع ضمانات فوق دستورية لتحصين الحقوق الكردية واعتماد النظام اللامركزي في الحكم”، مضيفاً: “هناك ثوابت يجب التعاقد عليها كيلا يتم التلاعب بها مستقبلاً”. كما أوضح أنه من المتوقع أن تطالب القوى السياسية الكردية بـ”تغيير اسم الدولة كي يكون معبّراً عن كل المكونات السورية، ويعبّر عن التنوع في البلاد، فضلاً عن الاعتراف باللغة الكردية ثانيَ لغةٍ في البلاد، ولغة أولى في المناطق التي يشكل الأكراد غالبية سكانها”. وأشار كدو إلى أن الإعلان الدستوري الناظم للمرحلة الانتقالية والذي صدر الأسبوع الماضي “لا يعبّر عن الواقع السوري وتطلعات المواطنين”، مضيفاً: “معظم السوريين لم يرحبوا بهذا الإعلان، ولا شك أن الأكراد سوف يطالبون بإجراء تغييرات جوهرية على الإعلان. نريد أن نكون شركاء حقيقيين في البلاد فهي بلد للجميع ومن ثم ستكون لدينا لائحة مطالب ذات شقين: وطني، وكردي”.
العربي الجديد
—————————-
سوريا وتجاوز ثنائيّة الأكثريّة والأقليّة!/ حسن المصطفى
سوريا اليوم في حاجة لأن تتجاوز فكرة ثنائية: العربي والكردي، المسلم والمسيحي، السني والشيعي، وألّا تنظر إلى الدروز والعلويين كأقليات، بل على الدولة الوطنية أن تكون حاضنة للجميع.
17-03-2025
لا يزالُ مفهوم “المواطنة” ملتبساً في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية، كون هذه المجتمعات لا تزال في حالة هجينة، لم تنتقل فيها تماماً إلى الدولة الوطنية الحديثة الناجزة، رغم أن عدداً منها مرت عليه عقود طويلة على الاستقلال، وجزء رئيس من هذا الخلل يعود إلى المنظومة المعرفية الهشة التي شُيدت عليها الأنظمة أو السياسات.
ثمة مفاهيم فلسفية أساسية تدخل في حقل “الفلسفة السياسية”، وهي بمثابة القاعدة الصلبة التي تشيد عليها مؤسسات الدولة، وتوزع وتفصل من خلالها السلطات، وتنتظم العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وأيضاً تُشكل الإطار المفاهيمي للدستور.
“المواطنة الشاملة” هي واحدة من أهم تلك المفاهيم، وهي إذ تحضرُ اليوم في الفضاء العربي – الإسلامي، فهي لا تُطل بوصفها قيمة ترفية، بل ركن ركين من دونه لا يمكن لمدماك الدولة الوطنية أن يستقر.
من تابع الأحداث الدموية والمواجهات العسكرية وعمليات التمرد والقتل والانتقام التي جرت في الساحل السوري، أخيراً، وراح ضحيتها أبرياء ومدنيون كثر – من دون الدخول في الجدل السياسي والغرق في وحول الإشاعات والمعلومات المضللة التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي – سيجد أن ما جرى يشير إلى قصور في فهم معنى “المواطنة” وإدراك كنهِها لدى شريحة واسعة من السياسيين والجمهور العام!
“المواطنة الشاملة” تعني في أبسط صورها أن الأفراد والجماعات في أي دولة، هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وأنه لا يجوز التمييز بينهم لأسباب عرقية أو دينية أو مناطقية، وهم بذلك لهم الحق في الحصول على فرصٍ متساوية، سواء في التعليم أم في العمل أم في الطبابة وسواها، وأيضاً يستطيعون التعبير عن ذواتهم الخاصة أو الجمعية، بشكل حرٍ ومن دون إكراهات.
هذا يقودنا بالتالي إلى أمرٍ يتجاوز المفهوم السائد لـ”الحقوق”، والقائم على تصورٍ منقوصٍ لـ”الديموقراطية” التي يتصور البعض أنها تعني حكم الأكثرية، وبالتالي يحق لهذه الأكثرية أن تضع ما تشاء من قوانين طالما كان ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها، وبقوة تصويت الأغلبية وتأييدها!
هذه النزعة فيها شيء من الاستعلاء وأيضاً يشوب ممارستها خللٌ كبير، لأنها سوف تنتهك مفهوم “المواطنة الشاملة” الذي يتجاوز التقسيمات القديمة: أكثرية وأقلية.
هذا التقسيم، يخلق تقابلاً يدفع نحو الصراع، وهو يتجاوز المنافسة السياسية إلى المناكفة وفرض ثقافة أعلى على أخرى أدنى!
وعليه، من الممكن أن يقود تقابلُ “الأكثرية” و”الأقلية” إلى تعميق القلق الاجتماعي وزرع بذور الريبة والشك المتبادل.
إن المجتمعات الحديثة في أوروبا على سبيل المثال، بنيت على مفهوم “المواطنة الشاملة”، وبالتالي تم تجاوز الثنائيات المتصارعة، لأن الجميع مواطنون، لهم هوياتهم الفرعية الخاصة، ولهم الحق في إبراز ثقافاتهم ومعتقداتهم، إنما ليس هنالك حق لأكثرية أن تضطهد أكثرية، ولا يمكن للأقلية أيضاً أن تتمرد على الأغلبية، لأن “المواطنة” تجعل المكونات المتجاورة محكومة بـ”القانون العادل” وتحت سقف الدولة المدنية.
سوريا اليوم بحاجة لأن تتجاوز فكرة ثنائية: العربي والكردي، المسلم والمسيحي، السني والشيعي، وأن لا تنظر إلى الدروز والعلويين كأقليات، بل على الدولة الوطنية أن تكون حاضنة للجميع، قادرة على تقديم خطاب وطني ترى فيه كل هذه المكونات ذاتها من دون انتقاص أو تضخم، ويفتح الطريق أمام بناء الدولة الحديثة وتنميتها.
هنالك واقعٌ صعب ومعقد في مجتمع عانى من حكم استبدادي طوال عقود خلت، وهو لا يزال لم يتداو من جراح الأحداث الدامية ما بعد عام 2011 وما جرته من مجازر وحروب أهلية؛ إلا أن هذا الإرث الثقيل من الوجع والعذابات يجب أن يكون حافزاً لبناء “مواطنة حقيقية” لا صورية، وأن يدرك الجميع أن الدم والثأر والكراهية والانتقام، كل هذه هي وصفات جاهزة للخراب الذي سيكون الجميع فيه خاسرون.
هذا الوعي المفاهيمي لا يمكن أن يحصل بين عشية وضحاها، بل لا بد من أن تبادر الدولة السورية والمجتمع المدني والقيادات الروحية والسياسية والمثقفين إلى بثِ روح وطنية واعية، تتسامى على الجراح، وتتجاوز الثنائيات المتجادلة والمتصادمة، وتذهب إلى مشاركة حقيقية في بناء الدولة وفق مشاريع عملية طموحة؛ و”المواطنة الشاملة” هي مفتاح رئيس لهذا التحول الذي ينشده السوريون وتتمناه لهم الدول والشعوب الصديقة.
النهار العربي
——————————-
هل تندلع الحرب بين أنقرة وتل أبيب على الساحة السورية؟!/ صالحة علام
20/3/2025
في تصعيد جديد ضد حكومة نتنياهو، صرّح الرئيس أردوغان بأن: “هناك قوى -لم يسمها- تحاول زعزعة الأمن والاستقرار داخل سوريا انطلاقا من إثارة النعرات الدينية والعرقية”، مؤكدا أن بلاده “لن تسمح بتقسيم المنطقة أو إعادة رسم حدوها بأطماع توسعية كما فعلوا قبل قرن من الزمان”، وأنهم سيجدون تركيا في مواجهتهم هذه المرة.
تصريحات أردوغان الجديدة جاءت ردا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة درعا، ومنطقة خان أرنبة في الجنوب السوري بالتزامن مع عودة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.
الموقف التركي من التحركات الإسرائيلية في المنطقة، التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية يبرز بقوة حجم المخاوف التركية من الأطماع التوسعية لدولة الاحتلال الصهيوني، والرغبة الجامحة لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق حلم نبوءة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
إذ سبق وأن حذر أردوغان من رغبة حكومة نتنياهو التي تقودها عقلية دينية متعصبة في التوسع جغرافيا على حساب الخريطة التاريخية لبلاده، والاستيلاء على مناطق الأناضول، تحقيقا لوهم الأرض الموعودة، والعمل على إقامة كيانات تابعة لها في كل من شمال العراق وسوريا عبر استغلال علاقاتها بالتنظيمات الانفصالية، في إشارة لعدد من الأقليات السورية الطامحة في الحكم الذاتي، ولقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لديها علاقات ممتدة بتل أبيب.
وكانت العديد من التقارير المتداولة إعلاميا قد أفادت أن توقيع قادة قوات سوريا الديمقراطية على اتفاق الاندماج داخل الإدارة الجديدة مع دمشق لم يقف حائلا دون استمرارهم في السعي لتأمين دعم إسرائيلي لهم في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة لهم، التي يحتاجون فيها -وفق رؤيتهم للتطورات بالمنطقة- لتوفير حلفاء وضامنين جدد لديهم القدرة على حمايتهم والوقوف إلى جوارهم.
وهو ما وافق هوى إسرائيل التي لا تنظر بارتياح لهذا الاتفاق، وترى أن تراجع الأكراد للخلف سيفسح المجال أمام عودة (داعش)، مما يضعها في موقف دفاعي صعب، إلى جانب شكوكها القوية وعدم ثقتها في الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي تمتد جذور انتماءاته إلى تنظيم القاعدة والجماعات الإسلامية الجهادية، مما قد يعرض أمنها للخطر، ويهدد وجودها.
ترى إسرائيل أيضا أن الجيش السوري الجديد الذي أُعيد بناء عناصره وتدريبهم بإشراف كامل من قيادات القوات المسلحة التركية، وتم تزويده بترسانة من الأسلحة المحلية المنتجة داخل هيئة الصناعات الدفاعية التركية أصبح يمثل خطرا من نوع آخر عليها، في ظل اتساع حجم النفوذ التركي داخل سوريا.
الذي يأتي متزامنا مع زيادة حدة التوترات وتفاقم خلافاتها مع أنقرة، على خلفية حربها ضد كل من قطاع غزة ولبنان، واختلاف أجندة كل منهما فيما يخص مستقبل الدولة السورية، إذ تعتقد إسرائيل أن تقسيم سوريا، وخلق كيانات متعددة بها من شأنه أن يضمن لها أمنها، ويمنحها الفرصة كاملة لتحقيق رغبتها في توسيع مساحتها.
ومن هذا المنطلق تدعم مطالب الحكم الذاتي لكل من الأكراد، والدروز، والعلويين، وتبذل جهودا مضاعفة حاليا من أجل دعم الطائفة الدرزية، حيث تم مؤخرا إرسال 10 آلاف طرد من المساعدات الإنسانية لأفرادها، وصرح جدعون ساعر وزير خارجية الكيان الإسرائيلي أن علاقاتهم بالدروز تاريخية، وأن عليهم الوقوف إلى جانبهم، لأنه “في منطقة نكون فيها أقلية، فمن الصواب دعم الأقليات الأخرى”.
أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس فصرّح أن حكومته قررت السماح للدروز من الجانب الآخر من الخط الفاصل بدخول هضبة الجولان والعمل بها، معربا عن استعدادهم للدفاع عنهم والوقوف إلى جوارهم دائما، بينما أعلن مسؤولون إسرائيليون أنهم لن يقبلوا وجود أي عسكري سوري في المناطق الجنوبية للعاصمة دمشق، وأنهم على أتم استعداد لغزو ضواحيها دفاعا عن الأقلية الدرزية المنقسمة بين إسرائيل وسوريا.
إلى جانب التصدي لمحاولات تركيا وأردوغان الرامية إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، واستعادة سيطرة بلاده على خريطة المنطقة كما كان عليه الحال في عهد الدولة العثمانية، وفي تقديم نفسها الوجود كقوة إقليمية فاعلة ذات نفوذ، لديها القدرة على التحكم في مستقبل المنطقة وفرض سيطرتها على مقدرات شعوبها، وهو ما يطلق عليه نتنياهو اسم “الشرق الأوسط الجديد”.
التحركات الإسرائيلية الداعمة للمطالب الانفصالية للأقليات السورية، والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد الأراضي السورية تنظر إليها أنقرة بريبة وشك، وتضعها في موقف الاستعداد لمواجهة تطورات الأمر بالسبل الممكنة كافة، حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية المباشرة.
لما تمثله هذه التحركات من تهديد مباشر لأمنها القومي، ومحاولة من جانب الكيان المحتل لتقويض مكانتها الإقليمية، وزعزعة استقرارها، والنيل من وحدة أراضيها عبر تشجيع الدعوات الانفصالية، ومساندة ودعم العناصر المسلحة التي تنتمي للتنظيمات الإرهابية لتخريب السلم الاجتماعي بالمنطقة.
وخلافا للرؤية الإسرائيلية التي تشجع على تقسيم سوريا وتعمل عليها، ترى تركيا أن وحدة الأراضي السورية، وإقامة دولة مركزية قوية ومستقرة بها من شأنه ضمان إخراج التنظيمات الانفصالية المسلحة، وإبعادهم تماما عن مناطق تمركزهم، والتخلص من تهديداتهم، بما يفسح المجال أمام الحفاظ على استقرار المنطقة، وإشاعة السلام بين شعوبها وتحقيق أمن دولها القومي.
ولتحقيق هذه الأهداف مجتمعة سعت أنقرة إلى زيادة حجم تعاونها العسكري مع دمشق عبر الاستعداد للتوقيع على اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، كما تم تعيين ملحق عسكري في السفارة التركية بدمشق، بينما قام مؤخرا وفد يضم كلًا من وزيري الخارجية والدفاع، ورئيس الاستخبارات بلقاء المسؤولين السوريين في دمشق، حيث تم تأكيد تمسك أنقرة بتسليم العناصر المسلحة لأسلحتها، وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، إلى جانب التباحث حول العديد من القضايا الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، التي من بينها بحث إقامة قاعدتين عسكريتين لتركيا في كل من دمشق وحمص، واستمرار عمليات تدريب الجيش السوري وتسليحه.
وهي التحركات العسكرية التي تراها إسرائيل تمثل تهديدا لها سواء على صعيد الجيش السوري الذي قد يصبح وكيلا لتركيا في حرب مباشرة ضدها، أو على صعيد تركيا نفسها التي يتزايد وجودها العسكري على الأراضي السورية، ودعمها المطلق لحكومة الشرع المؤقتة، وتزايد تهديداتها والتصعيد المستمر في خطابها العدائي ضد إسرائيل سواء من الرئيس أردوغان أو كل من وزيري خارجيته ودفاعه.
ما يبدو أنه شجع الشرع على التخلي عن أسلوبه الذي اتسم باللين تجاه إسرائيل منذ وصوله إلى دمشق، ليستخدم أسلوبا أشد حدة في الخطاب الذي ألقاه مؤخرا في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بالقاهرة، حينما قال: “إن توسع العدوان الإسرائيلي ليس انتهاكا للسيادة السورية فحسب، بل هو تهديد مباشر للأمن والسلام في المنطقة بأسرها”.
تعزيز تركيا لقدراتها العسكرية وتطوير دفاعاتها الهجومية وصواريخها الباليستية، وتعاونها المطلق مع سوريا في المجال العسكري تحديدا، وتصعيد تصريحات مسؤوليها ضد تل أبيب ينبئ بأن هناك استعدادات تجري انتظارا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة التي قد تشهد اشتباكا مسلحا بينها وبين إسرائيل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق غير مباشر.
المصدر : الجزبرة مباشر
كاتبة وصحفية مصرية مقيمة في تركيا
حاصلة على الماجستير في الاقتصاد.عملت مراسلة للعديد من الصحف والإذاعات والفضائيات العربية من تركيا
———————————
سورية… فيدرالية الأمر الواقع!/ أحمد مولود الطيار
20 مارس 2025
يرى كثيرٌ من السوريين أنّ أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ”الجولاني”، هو “رجل المرحلة” والضمانة الوحيدة لعدم انزلاق سورية نحو المجهول، حتى إنّ بعضهم بات يردّد مقولةً مستعارة من النظام السابق مفادُها أنّه لا يوجد بديلٌ قادرٌ على إنقاذ البلاد.
غير أنّ هذا الطرح يواجه انتقاداتٍ جوهرية؛ إذ إنّ استمرار الشرع في السلطة قد يؤدّي إلى تفتيت سورية إلى دويلاتٍ وكياناتٍ طائفيةٍ وعرقيةٍ متجاورة، ممّا يجعلها عُرضةً لصراعاتٍ أهليةٍ متكرّرة قد تهدأ لفترةٍ ثم تشتعل مجدّدًا طالما بقي في موقع الحكم. يُضاف إلى ذلك أنّ الشرع نفسه، والجماعة التي كان يقودها (هيئة تحرير الشام)، يقفان حجر عثرةٍ أمام رفع العقوبات الأميركية المنصوص عليها في “قانون قيصر”.
منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر/ كانون الأوّل 2024، وتولّي أحمد الشرع رئاسة سورية، تمرّ البلاد بتحوّلات عميقة تعيد رسم خريطة النفوذ والسيطرة. ويبدو أنّ البلاد أصبحت مقسّمة فعليًّا بين قوى مختلفة، لكلٍّ منها تحالفاتها وحساباتها الخاصة، ممّا يثير تساؤلاتٍ حول ما إذا كان الشرع قد وافق ضمنيًّا على تقسيم سورية أم أنّه وجد نفسه مضطرًّا للتعامل مع واقع جديد مفروض عليه. ففي الجنوب، تبدو السويداء وكأنّها منطقة مستقلة بحكم الأمر الواقع، حيث لا يملك “الجيش العربي السوري” القدرة على دخولها أو فرض سيطرته عليها. يعود ذلك إلى عدّة عوامل، أبرزها التهديدات الإسرائيلية المباشرة، إذ أكّدت حكومة نتنياهو مرارًا أنّها لن تسمح بوجود أيّ قوةٍ عسكريةٍ تهدّد الدروز هناك. كما أنّ بعض القيادات الدرزية ومشايخ العقل لا يخفون وجود قنوات تواصل مع إسرائيل التي باتت تُعتبر بالنسبة لهم ضمانة لحماية مصالحهم وسط اضطرابات المشهد السوري. هذا التفاهم غير المعلن جعل السويداء عمليًّا خارج سيطرة دمشق، أشبه بمنطقةٍ ذات حكمٍ ذاتيٍّ غير رسمي.
في الشرق، وحيث تمتدّ منطقة الجزيرة السورية التي تشكّل 41% من مساحة سورية، فالوضع لا يقلّ تعقيدًا. فهذه المنطقة الغنيّة بالنفط والموارد الطبيعية بقيت خاضعةً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، رغم تغيّر القيادة في دمشق. وتشير المعطيات إلى أنّ الاتفاق بين الشرع و”قسد” أرسى نوعًا من التفاهم الهش، بحيث تحافظ الإدارة الذاتية الكردية على استقلاليتها مقابل تفاهماتٍ شكليةٍ تتعلّق بالسيادة مع الحكومة الجديدة. ولم تعد العلاقة بين واشنطن و”قسد” مجرّد تحالفٍ تكتيكي، حيث تستخدم الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية “عند الحاجة” كما يردّد البعض، بل تحوّلت إلى شراكةٍ استراتيجية، إذ ترى الولايات المتحدة في “قسد” شريكًا مهمًّا لضمان الاستقرار في المنطقة، بينما تعتمد القوات الكردية على الدعم الأميركي لتأمين استقلالية قرارها بعيدًا عن دمشق. في ظلّ هذا الوضع، لا يملك الشرع خيارًا سوى القبول بهذا الترتيب، ممّا يعني أنّ الجزيرة السورية أصبحت فعليًّا خارج السيطرة المركزية.
أمّا الساحل السوري، وإن بدا حاليًا ضمن النفوذ المركزي لدمشق، إلا أنّ مستقبله غير محسوم، خصوصًا بعد التطوّرات الأخيرة. فقد تآكلت شرعية النظام بين العلويين ولم تعد مضمونة، وهذا على افتراض أنّها كانت موجودة سابقًا، ما يفتح الباب أمام سيناريوهاتٍ مختلفة، من بينها تعزيز الحكم الذاتي أو البحث عن تحالفاتٍ جديدةٍ تضمن استقراره. وفي ظلّ هذا المشهد، يرى بعض المراقبين أنّ المناطق المتبقية تحت سيطرة الشرع باتت تشكّل ما يشبه “كانتونًا سنّيًّا”، حيث يسعى إلى موازنة علاقاته مع القوى الدولية والإقليمية لضمان بقائه. وهو يدرك أنّ الاعتراف الدولي بحكمه لن يتحقّق إلا إذا التزم بحدودٍ واضحة مع إسرائيل جنوبًا، وتجنّب أيّ مواجهة مع “قسد” شرقًا، وضمان مصالح تركيا شمالًا. وبهذا، تبدو حدود مناطق نفوذه مرسومةً بوضوح، من دون أن يكون قادرًا على توسيعها من دون الدخول في صدام مع القوى الفاعلة في الملف السوري.
وعلى الرغم من أنّ الشرع لا يصرّح علنًا بموافقته على تقسيم البلاد، فإنّ تحرّكاته وتفاهماته مع القوى الإقليمية والدولية تعكس قبوله ببقاء مناطق النفوذ الحالية طالما أنّها لا تهدّد سلطته في دمشق. فالسويداء تبقى خطًا أحمر بالنسبة لإسرائيل، والجزيرة محميّة أميركية بحكم الواقع، والشمال يخضع للتأثير التركي المباشر، بينما تحتفظ دمشق ومحيطها بسيطرة الشرع، مع تقديمه بعض التسهيلات الاقتصادية والسياسية لضمان اعترافٍ دولي ولو كان مشروطًا. وبذلك، يبدو أنّ أحمد الشرع قد اختار التعايش مع هذا الواقع بدلًا من خوض مواجهةٍ عسكرية مع القوى الكبرى والإقليمية التي ترسم حدود النفوذ في سورية. فالتقسيم غير المعلن بات أمرًا واقعًا، حيث تتقاسم البلاد قوى متعدّدة، فيما يحرص الشرع على تثبيت موقعه ضمن هذه الخريطة الجديدة، ولو كان ذلك على حساب وحدة سورية الكاملة.
وبعيدًا عن التدخّلات الدولية وصراع المصالح الإقليمية، يبقى الخطر الأكبر على وحدة سورية هو سياسات أحمد الشرع نفسه. فمنذ وصوله إلى السلطة، لم يقدّم مشروعًا وطنيًّا حقيقيًّا يهدف إلى إعادة توحيد البلاد، بل اعتمد على سياسة إدارة الأزمات عوضًا عن حلّها. وقد أدّى هذا الاستئثار بالحكم إلى عددٍ من المخاطر، أبرزها تعميق الانقسامات الطائفية والمناطقيّة، حيث بات لكلّ منطقة إدارتها الخاصة وعلاقاتها الخارجية المستقلة، ممّا يعزّز احتمالات التفتّت على المدى البعيد. بالإضافة إلى إقصاء القوى السياسية الأخرى، حيث لم يبادر الشرع إلى إشراك القوى الفاعلة في حوارٍ وطنيٍّ حقيقي، بل اكتفى بعقد تفاهماتٍ مع جهاتٍ خارجيةٍ للحفاظ على سلطته، ممّا أضعف إمكانية بناء دولةٍ مركزيةٍ متماسكة. كما استمرّ في ترسيخ حكم الفرد بدلًا من بناء مؤسساتٍ قويّة، ما يجعل البلاد أكثر هشاشةً أمام أيّ أزمةٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ مستقبلية.
في الوقت الحالي، يبدو أنّ السلطة في دمشق تعمل وفق معادلة “التكيّف مع الأمر الواقع” بدلًا من السعي إلى مشروعٍ وطنيٍّ يوحّد السوريين. ولكن يمكن للشرع تبنّي نهجٍ جديدٍ قائمٍ على حوارٍ وطنيٍّ شاملٍ وحقيقي يشمل جميع المكوّنات السورية، من الأكراد إلى الدروز إلى العرب السنّة والعلويين، إضافةً إلى إصلاحاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ حقيقيةٍ تعيد ثقة المواطنين بالدولة عوضًا من الرهانات على الدعم الخارجي. وذلك كفيلٌ بإطلاق إعادة إعمارٍ متوازنةٍ تشجّع اللاجئين والنازحين على العودة إلى مناطقهم، ممّا يعيد توزيع النفوذ الداخلي. ولكن نجاح هذا الحلّ يتطلّب إرادةً سياسيةً قوية، وهو ما لم يظهر حتى الآن لدى الأطراف المتحكّمة بالمشهد.
السيناريوهات القادمة التي تنتظر سورية كثيرةٌ ومفتوحةٌ على احتمالاتٍ شتّى، وأحد تلك السيناريوهات أن يبقى الوضع الحالي كما هو عليه من دون إعلانٍ رسميٍّ للتقسيم؛ حيث تحافظ دمشق على سيطرتها على بعض المناطق، بينما تستمرّ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد، ويبقى الشمال السوري خاضعًا للنفوذ التركي، والجنوب تحت تأثير إسرائيل بشكلٍ غير مباشر. وقد تحدث تحوّلاتٌ تدريجيةٌ، مثل توقيع اتفاقياتٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ بين مختلف الأطراف، ممّا يؤدّي إلى نوعٍ من “الكونفيدرالية غير الرسمية”. وفي ظلّ الوضع الحالي، قد يبدو هذا السيناريو الأكثر واقعيةً على المدى القريب؛ إذ لا تزال الأطراف المتصارعة غير قادرةٍ على فرض حلٍّ نهائي. أمّا على المدى البعيد، فقد تتّجه سورية نحو أحد السيناريوهين: الفيدرالية الموسّعة أو إعادة توحيد الدولة، وذلك بناءً على مدى قدرة القوى الداخلية على تجاوز الانقسامات، ومدى استعداد الدول الكبرى لدعم حلٍّ شامل. أمّا السيناريو الأسوأ فهو التفكّك الكامل، لكنّه يظلّ أقلّ احتمالًا حاليًّا، لأنّ معظم الأطراف الإقليمية والدولية ترفض تقسيم سورية رسميًّا.
العربي الجديد
————————
الدفاع التركية: أبلغنا دمشق بتحفظاتنا حول اتفاقها مع “قسد“
2025.03.20
أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة أبلغت الجانب السوري بتوقعاتها وتحفظاتها بشأن ما يجب القيام به ميدانياً فيما يتعلق بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكدت المصادر أن “تركيا تتابع عن كثب المستجدات في سوريا، وتواصل اتصالاتها مع الجانب السوري لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي والإنساني والصناعي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات الدفاعية لسوريا وإعادة إعمارها وتنميتها”.
وأشارت إلى أن “تحديد الاحتياجات العاجلة لسوريا وإيجاد الحلول المناسبة لها يمثل أولوية، وفي هذا السياق، يمكن تعيين مستشارين عسكريين أو أفراد ارتباط في وزارات الدفاع لدى الجانبين”.
إعادة تموضع القوات التركية في سوريا
وأضافت المصادر أن “تركيا مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم من أجل رفاه الشعب السوري واستقراره وأمنه، وتواصل العمل على تحقيق ذلك”، مشيرةً إلى أن “عناصرنا المنتشرة في سوريا قد تشهد تعديلات في مواقعها وفقاً للتطورات الجديدة، والأنشطة الميدانية في هذا الإطار مستمرة”.
وفيما يخص الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أكدت المصادر أن “أنقرة أبلغت نظراءها بتوقعاتها وتحفظاتها بشأن ما يجب القيام به ميدانياً في هذا الشأن”.
كما لفتت إلى أن وزير الدفاع التركي، إلى جانب وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MİT)، زاروا سوريا الأسبوع الماضي، مؤكدةً أن “الزيارة تمحورت بالكامل حول بحث الدعم الذي يمكن لأنقرة تقديمه لإرساء الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، وتم خلالها مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالأمن الإقليمي”.
——————————————-
فيدان: يجب أن ينال الكُرد السوريون حقوقهم وحكومة دمشق مهتمة بذلك
2025.03.20
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة أن ينال الكُرد في سوريا الحقوق التي لم يحصلوا عليها في عهد نظام الأسد المخلوع، مشيراً إلى أن الحكومة السورية الحالية لديها اهتمام كبير بتنفيذ هذا الأمر.
وقال فيدان في تصريحات للصحفيين خلال مأدبة إفطار جماعي، اليوم الخميس: “يجب أن يعامل الجميع في سوريا باعتبارهم مواطنين متساوين”، مؤكداً أن حكومة دمشق تهتم كثيراً لتحقيق ذلك، وفق وكالة الأناضول.
وأوضح أن مسألة وجود تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” في سوريا، شكلت محور محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الفائت في دمشق.
وأشار فيدان إلى أن جميع القضايا والمخاوف التي تُشكل أولوية بالنسبة لتركيا طُرحت خلال الاجتماع مع الشرع. وأضاف: “في إطار الاتفاق الذي أبرمته الإدارة السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبّرنا بوضوح عن وجهة نظرنا بشأن قضايا مثل نوايا التنظيم وقدراته وسيطرته على موارد الطاقة”.
وقال فيدان: “سلّطنا الضوء على القضايا التي قد تُثير القلق في إطار خبرتنا الطويلة في مكافحة الإرهاب. ورأينا أن الإدارة السورية تُشاركنا النوايا نفسها والمنظور نفسه”. ولفت إلى أنه ناقش مع الشرع، الخطوات التي ستتخذها “قسد” والجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الإدارة السورية.
وأردف: “هناك قضية أخرى مهمة أيضاً، وهي العناصر الذين انضموا إلى قسد من خارج سوريا، لا يمكن لهؤلاء العناصر الوجود في سوريا، يجب عليهم أن يلقوا أسلحتهم، ويُلغوا أنفسهم، وتخضع كامل الأراضي السورية لسيطرة الحكومة المركزية، هذا أمرٌ لا مفر منه. يجب أن تكون الحكومة المركزية قادرة على تولي زمام الأمور”.
ولفت فيدان إلى أن تركيا “عبّرت في جميع المحافل الدولية والإقليمية عن دعمها المطلق لوحدة سوريا وسلامة أراضيها”.
مصير القوات الأميركية في سوريا
وبشأن الوجود الأميركي في سوريا، قال فيدان إن استمرار وجود القوات الأميركية في سوريا ليس من أولويات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، مؤكداً أن دول المنطقة ستتعاون فيما بينها من أجل إنهاء تهديد تنظيم الدولة (داعش).
وأوضح أن “وجود الجيش الأميركي في سوريا له ثمن. وقد أصبح استمرار وجوده موضع تساؤل لدى الرأي العام الأميركي. في السابق كانت هناك عوامل مثل الوجود الإيراني والروسي ونظام الأسد في سوريا. لكن الوضع تغير الآن”.
وأشار فيدان إلى ضرورة إقناع ترمب بعدم جدوى استمرار وجود الجنود الأميركيين في سوريا، قائلاً: “إذا سحبت أميركا جيشها، فسيكون ذلك أقل كلفة عليهم”. مضيفاً أن دول المنطقة ستعمل معاً من أجل القضاء على التهديدات الصادرة عن تنظيم “داعش”.
————————–
أن تستعيد سوريا كُردها: عن الأسئلة السياسية أمام سوريا بخصوص القضية الكردية/ بشير أمين
21-03-2025
شهدت سنوات الثورة السورية انفتاحاً ثقافياً ملحوظاً على الكرد السوريين، خاصة ضمن التيارات الديمقراطية وبين أوساط الليبراليين السوريين، الذين أدركوا حجم التهميش والاضطهاد الذي تعرض له الكرد. برزت رغبة واضحة لفهم قضاياهم، إلى جانب اهتمام ثقافي بتعلم لغتهم وموسيقاهم. في أول نوروز بعد سقوط النظام الأسدي، شهدت ساحة الكرامة في السويداء ومناطق سورية أخرى احتفالات عشية العيد، وغنى الفنان السوري سميح شقير أغانيه الثورية لأول مرة في نوروز القامشلي، من بينها «لي صديق من كردستان»، إلى جانب أغنيات أخرى، في مشهد مبشر بانفتاح جديد لسوريا على الكرد السوريين.
ولكن، ما الذي ينقص هذا التفاعل الإيجابي كي تكتمل الفرحة؟ وهل يمكن القول إن سوريا قد «استعادت» كُردها بالفعل، كما أراد البعض أن يصف اتفاق السلطة الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية؟
زوال نظام الأسد يشكل بالفعل زوال العائق الأكبر أمام المسألة الكردية، إلا أن هناك قضايا أخرى ما زالت عالقة وتحول دون قدرة سوريا من استيعاب كُردها. بعض هذه العوائق بعمر الدولة السورية نفسها، وتسبق ظهور نظام البعث وفترة حكم الأسدين. يُطلب من سوريا، أولاً، إعادة بناء الثقة ومد الجسور لإصلاح ما أفسدته سنوات الحرب السورية. وثانياً، وربما الأهم، تعزيز هذه الخطوات من خلال إجراءات سياسية ملموسة تثبت بدء عهد جديد، بالتوازي مع انفتاح اجتماعي وثقافي حقيقي على الكرد السوريين، وفهم أعمق لواقعهم وتطلعاتهم.
لا يمكن اختصار المسألة الكردية في سوريا تحت عنوان واحد مثل «القضية الكردية»، لأن ذلك يؤدي إلى اختزال المسألة في حقوق قومية أو ثقافية فقط، وأحياناً في حقوق المواطنة وحسب. معالجة المسألة الكردية تستدعي فهم وجود مجموعة من التقاطعات التي تشكل «قضايا كردية» متعددة تتطلب الحل والانتباه.
في الجانب القومي، تتجاوز المسألة الكردية مجرد ضمان حقوق الأفراد في دولة مواطنة، إنما يكمن جوهر هذه القضية حول حقوق الكرد كجماعة تعرّف نفسها بوصفها جماعة سياسية. فإلى جانب حرمان السوريين عامة من ممارسة الحق السياسي في ظل الأسديّة، تعرض الكرد لإلغاء هويتهم الثقافية وكينونتهم القومية. وعليه، تفرض ضرورات المرحلة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة الاعتراف بما تعرض له الكرد من إقصاء واستهداف وجودي كجماعة بشرية. فقد خلت الدساتير السورية المتعاقبة من أي اعتراف بوجود الشعب الكردي على الأرض السورية، فضلاً عن إقصائهم من المشاركة في بناء الدولة وهويتها. ويستلزم هذا الاعتراف سعياً جاداً لإيجاد آليات تعويض تعيد ما سُلب من حقوقهم المادية والمعنوية.
ما يعقّد المسألة القومية بالنسبة للكرد هو وجود اتصال جغرافي، اجتماعي، وسياسي بين الكرد في سوريا وأقرانهم في الأجزاء الأخرى من كردستان. ورغم عدم واقعية هذا الحلم، فإن فكرة إقامة دولة كردستان تظل رغبة شعبية ومحركاً أساسياً للعمل السياسي الكردي. وبالتالي، فإن الانتماء لسوريا كدولة حديثة، «دولة-أمة»، يفتقر إلى عامل توفير هوية جامعة للكرد، أي عامل «الأمة». فقد حافظ المجتمع الكردي على مقومات «الأمة»، ولكن خارج إطار الجسم السوري. بمعنى آخر، ينظر الكرد إلى التوجه نحو دمشق على أنه تنازل عن حق قومي تمتع به جيرانهم في الدول القومية الأخرى. وغياب هذا العامل الجامع انعكس سلباً على حقهم في الهوية السياسية قبل الثقافية، وسلب الانتماء «للأمة».
دفع هذا الإقصاء بالكرد إلى التقوقع ضمن هويتهم القومية، وفي بعض الأحيان شكّل عامل تخبّط لدى الحركة السياسية الكردية، وتطور أحياناً إلى اختلاف وشرخ بين القوى السياسية والقوى المجتمعية والمدنية. كما نشهد الآن توجه التيار اليساري المتمثل بالإدارة الذاتية نحو فكرة «المجتمعات الديمقراطية» و«أخوة الشعوب» والتخلي عن الخطاب القومي التقليدي، في حين يرفضه المزاج الشعبي العام لغياب العامل القانوني الذي يحفظ لهم الهوية الثقافية. وهذا يحتوي أيضاً على غياب للثقة بأي سلطة جديدة.
إعادة الثقة بين هذه المجتمعات لا تكفيها الفعاليات الثقافية والمشاركة في الاحتفالات أو التحدث ببعض اللغات، كما يحدث مع المجتمعات الأصلية والشعوب الأولى في أمريكا الشمالية. لأن في الشرق الأوسط، جميع الشعوب الموجودة هي شعوب أصلية، وعامل الاستعمار هنا لا يشبه الاستعمار الأوروبي لكندا والولايات المتحدة. وبالتالي، فإن اعتبار الكرد «مجتمعاً» دون اعتبارهم جزءاً مؤسساً ومشاركاً فاعلاً في صناعة هوية الدولة، لن يعيد الثقة.
العامل الرئيس في بناء الثقة هو عامل مادي. يتطلب استرجاع الأراضي المسلوبة خلال سنوات الحرب السورية، إعادة المهجرين إلى بيوتهم، والبدء فوراً بمسار العدالة الانتقالية الذي يتضمن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الكرد واليزيديين من قبل فصائل ثورية. ربما ينتظر الكرد تعويضاً عما سلبهم إياه نظام الأسد، وهذا حق لابد من العمل من أجله. لكن ما هو أكثر إلحاحاً، ومن شأنه تخفيف الاحتقان الإثني، هو محاسبة الجرائم التي ارتكبتها الفصائل الثورية، لأن استمرار هذه الجرائم قد يعني انتصاراً لجانب على آخر. بالمقابل، يترتب على ذلك إحالة جميع الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية إلى ملف العدالة الانتقالية بالميزان ذاته.
كل من هذه الجوانب يتضمن أيضاً جوانب فرعية. على سبيل المثال، الجانب الثقافي لا يقتصر على إبراز الهوية، بل يعاني المجتمع الكردي من مسألة تهميش المركز للأطراف (ويشترك الكرد في ذلك مع دير الزور والرقة). لذلك، يُطلب من النخب المدينية السورية أيضاً فهماً أوسع لعمق هوية الريف والمجتمع العشائري والعزلة التي عانت منها هذه المجتمعات. فحين يشعر الفرد الكردي أو الجزراوي بقبول المجتمع المديني له في مثل دمشق وحلب، سيشعر حينها بالانتماء للنسيج المجتمعي السوري، ولن يبقى باحثاً عن هويات فرعية.
الانفتاح الشعبي على الثقافة الكردية قد يلامس مشاعر الكرد بشكل آني، لكنه لا يظهر كافياً لإعادة بناء الثقة أو ما يكفل انتماء الأكراد للهوية السورية. يبقى هذا الانفتاح في كثير من الأحيان محصوراً في دوائر ضيقة ونطاقات نخبوية الطابع، لا تستطيع مجاراة خطاب شعبوي مسموم يخوض حروباً على الوجود الكردي ويحاول بشتى الوسائل منع تشكيل كينونة سياسية. ويُدفع بذلك نحو إبقاء المسألة الكردية مجرد مسألة ثقافية، أو مسألة أفراد ومواطنين كرد، لا جماعة سياسية.
موقع الجمهورية
—————————-
“قواعد وضباط”.. ما المطروح على طاولة أنقرة ودمشق العسكرية؟
ضياء عودة – إسطنبول
20 مارس 2025
الخطوات التي اتخذتها تركيا في سوريا بعد سقوط نظام الأسد تشي بأنها تنوي وتسعى لترسيخ شيء ما وجديد على الصعيد العسكري، وكان هذا الأمر انعكس مؤخرا بسلسلة زيارات وعدة قرارات وتصريحات عبّرت من خلالها أنقرة عن استعدادها لتقديم الدعم، في وقت ألمحت إلى حقبة جديدة أبعد من شراكة وأقرب إلى تحالف تام.
تعتبر تركيا أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة على عدة مستويات، وكان هذا البلد تابع عملية إسقاط نظام الأسد بـ”هدوء”، وهو ما أكدته التعليقات التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بعد سيطرة فصائل “إدارة العمليات العسكرية” على مدينة حلب.
ويقول خبراء ومراقبون الآن إنها تسعى إلى تثبيت واقع عسكري جديد يتناسب مع التغير الكبير الذي طرأ على مشهد سوريا السياسي والأمني ككل.
وقد يكون هدفها من وراء تثبيت هذا الواقع الجديد دعم إدارة أحمد الشرع من جهة، ولضمان أمنها مع جارة لطالما خيمت على الحدود الرابطة معها الكثير من الهواجس والتهديدات.
ولا يعني ما سبق أن أي خطوة عسكرية جديدة لتركيا لن تقابلها أية “مخاطر”، وهو ما يشير إليه الباحث في مؤسسة “سنتشوري إنترناشونال”، آرون لوند.
وعلى مدى الأيام الماضية لم تنقطع التقارير التي تفيد بنية تركيا إقامة قواعد عسكرية في سوريا. وجاء ذلك عبر وسائل إعلام تركية ومن خلال وكالة عالمية مثل “رويترز” التي نقلت عن مصادر قبل شهرين أن القواعد التي تنوي أنقرة تأسيسها ستكون في وسط سوريا.
وبينما ظلّت المعلومات التي نشرتها “رويترز” في إطار التحليلات صدرت عدة تصريحات تركية، خلال الأيام الماضية، وأشار عبرها المسؤولون إلى نيتهم دعم الإدارة السورية الجديدة، وتقديم كل ما يلزم لها على الصعيد العسكري “في حال طلبت ذلك”.
وبدأ المسار العسكري الجديد والرابط بين تركيا وسوريا بعد ذلك يتضح شيئا فشيئا، ليصل إلى مرحلة تعيين وزارة الدفاع التركية ملحق عسكري لها في دمشق، والحديث عن نيتها تعيين ضباط أتراك لتقديم الاستشارات العسكرية، وفق وسائل إعلام.
كما ذكرت صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة، قبل أيام، أن أنقرة بصدد “تدريب الجيش السوري الجديد”، وأنها مستعدة لإعادة هيكليته، بناء على الواقع الجديد الذي باتت عليه البلاد.
“لتركيا فرصة”
ويعود النفوذ العسكري التركي في سوريا إلى عدة سنوات للوراء.
وكان الجيش التركي قد ثبت عدة قواعد في شمال سوريا ونشر الآلاف من قواته هناك، في خطوات نفذها بالتالي، وقال إنها تهدف لحماية أمن تركيا القومي.
ضَمن التواجد التركي في شمال سوريا لعدة سنوات عدم تقدم قوات نظام الأسد باتجاه المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
ولعب دورا رئيسيا أيضا في العمليات العسكرية التي كانت تشنها تركيا ضد “وحدات حماية الشعب” في شرق سوريا، بالإضافة إلى دور آخر على صعيد الدوريات وعمليات المراقبة، التي كانت تجري مع الجانب الروسي.
وبعد سقوط نظام الأسد كان لابد من تغيير شكل المهام العسكرية التركية في سوريا، وخاصة أن من كان يعارض التواصل والتنسيق في دمشق بات مخلوعا في موسكو، في إشارة من لوند إلى نظام الأسد.
والآن يقول الباحث لموقع “الحرة” إن الحكومة السورية الجديدة بحاجة ماسة إلى الدعم الخارجي لبناء قواتها المسلحة، لاكتساب القوة والتطور، ولتجاوز الوضع الراهن للفصائل والجماعات.
ويضيف أن “تركيا في وضع جيد لتقديم هذا الدعم، وقد تدعمها قطر في ذلك”.
ولدى تركيا فرصة لترسيخ مكانتها كراعٍ رئيسي للحكومة السورية الجديدة، وفقا للباحث الذي يوضح أنها قد تأمل في تحويل سوريا إلى منصة لبسط نفوذها الخارجي، ولجعلها بوابة لدخول دبلوماسيتها رفيعة المستوى في الصراع العربي الإسرائيلي.
لكن الأهم من ذلك كله، هو أن تركيا سترغب في التدخل في سوريا “لحماية مصالحها القائمة وحماية حدودها”، كما يردف الباحث في “سنتشوري إنترناشونال”.
ويشرح بالقول: “أنقرة تخشى الفوضى على حدودها الجنوبية، وتريد حكومة موالية وموثوقة في دمشق تساعد في مواجهة حزب العمال الكردستاني والتهديدات الأخرى”.
كما تريد أنقرة، بحسب لوند أن تكون سوريا مستقرة وأن تتعافى اقتصاديا، حتى يتسنى إعادة اللاجئين.
ولتحقيق كل هذه الأمور، وللحماية من الفوضى والنمو المستقبلي المحتمل للمصالح العدائية جنوب حدودها، سيتعين على تركيا التدخل، بأي شكل من الأشكال العسكرية، وفقا للباحث.
“مزود أمني”
وتدرك تركيا أن سوريا لا تملك القدرات اللازمة لحماية سيادتها في الوقت الحالي، أو حتى الدفاع عن نفسها.
وعلى أساس ذلك يرى الباحث السياسي والأمني التركي، عمر أوزكيزيلجيك أنها تعبر عن استعدادها لسد هذه الفجوة “كمزود أمني”.
لكن أوزكيزيلجيك يقول في المقابل إن تركيا لا تريد التسرع، بل تسعى إلى إنشاء قواعدها بشكل تدريجي وعلى مدى فترة من الزمن، كما أنها تفضّل انتظار الجانب السوري، حتى ينتهي من تشكيل حكومة انتقالية.
وفي هذا السياق، ترغب تركيا أيضا في دعم وتدريب “الجيش السوري الجديد”، حيث تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، مستندةً إلى تجاربها في كوسوفو، وليبيا، والصومال، وأفغانستان، وقطر، وغيرها، وفق الباحث الأمني.
ما المطروح على الطاولة؟
وتذهب بعض الترجيحات الآن إلى أن أنقرة قد توقع اتفاقية دفاع مشترك مع دمشق، في خطوة قد يتغير على إثرها الكثير، خاصة على صعيد بقية الدول اللاعبة على الأرض وفي الجو. كإسرائيل.
وتذهب ترجيحات أخرى باتجاه أن الجيش التركي قد ينشئ قواعد عسكرية جديدة، دون أن تعرف حدودها وما إذا كانت ستتموضع في شمال سوريا أو تصل إلى مناطق لم يكن من المتخيل أن تصل إليها تركيا.
ويوضح الباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش أن تركيا تولي أهمية كبيرة لنجاح الدولة السورية الجديدة وإعادة بناء مؤسساتها، ولاسيما العسكرية.
ويقول لموقع “الحرة” إن تلك الأهمية ترتبط بفكرة أنه “بدون مؤسسة عسكرية قوية لا يمكن لسوريا أن تتعامل مع التحديات الكبيرة الداخلية والخارجية، خصوصا على مستوى الأمن”.
“أنقرة لن تدخر أي جهد يمكن أن تقدمه في سبيل مساعدة سوريا لتحقيق هذا الهدف”، يضيف الباحث.
ويشير إلى أن تركيا يمكن أن تقدم المساعدة لسوريا على أكثر من مستوى، سواء على مستوى تقديم الاستشارات أو إعادة بناء مؤسسة عسكرية محترفة، وصولا إلى حد تسليح الجيش السوري الجديد.
ولا يستبعد توقيع اتفاقيات دفاع مشترك، قائلا إنها مطروحة على الطاولة، وإن الإعلان عنها سيكون عندما تكون الظروف مناسبة.
و”الجيش السوري الجديد” المراد تشكيله في سوريا يضم عدة فصائل عسكرية كانت مدعومة عسكريا ولوجستيا من تركيا.
ولدى الجانب التركي أيضا تواصل فعال مع “هيئة تحرير الشام” وأحمد الشرع الذي كان يقودها قبل تنصيبه رئيسا انتقاليا لسوريا.
“مخاطر”
ورغم أن أنقرة قادرة وتنوي بالفعل الشروع بعدة خطوات عسكرية على صعيد الاتفاقيات أو تقديم الدعم وإعادة هيكلة الفصائل المسلحة، إلا أن هذه الخطوات تكمن في قبالتها الكثير من “المخاطر”، بحسب الباحث آرون لوند.
فمن خلال الاستثمار العسكري في سوريا، ستُثقل تركيا كاهلها بمسؤولية أكبر تجاه حكومة لا تزال ضعيفة للغاية وقد تتطلب دعما مكلفا لتؤدي مهامها.
كما أن دورا تركيا أكبر في سوريا قد يضع القوات التركية في مواجهة مع إسرائيل، مما يرفع درجة التنافس بينهما إلى مستويات قد لا تكون أنقرة مرتاحة لها، بحسب الباحث.
ويشير أيضا إلى أن تقديم الدعم المباشر لقطاع الأمن في سوريا بقيادة أحمد الشرع قد يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية.
وسوريا ليست فقط تحت العقوبات، بل لا تزال “هيئة تحرير الشام” جماعة مصنفة إرهابية في نظر الولايات المتحدة وأوروبا، بل والأمم المتحدة.
و”حتى لو تسامحت الإدارة الأمريكية مع مثل هذا الدعم الآن”، فلا يوجد ما يضمن أن دونالد ترامب لن يغير رأيه لاحقا، بحسب الباحث في “سنتشوري انترناشونال”.
ويعتقد الباحث علوش أن أي حديث عن نية تركيا إنشاء قواعد جديدة في سوريا هو “جزء من الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين أنقرة ودمشق”.
ويقول الباحث إن “أي حضور تركي عسكري في سوريا ستحدده حاجة البلدين بطبيعة الحال لأن هذا القرار سيادي يتعلق بهما”.
“أنقرة حريصة بدرجة أساسية إلى تعظيم قدرة سوريا في النهوض في هذه المرحلة ومواجهة التحديات التي تهدد استقرارها وأمنها، لأن نجاح سوريا والتجربة السورية هي حاجة أمن قومي لتركيا”، يضيف علوش.
ويؤكد أنه “لا يمكن لتركيا تحمل فشل التحول في سوريا وفشل الدولة في بناء مؤسساتها ولاسيما العسكرية. هناك حدود طويلة ولا يمكن أن تكون آمنة دون وجود مؤسسة عسكرية قادرة على ضبط الأمن”.
ورغم أن تركيا هي الفاعل الأكثر نفوذا في سوريا بلا شك إلا أنها لا تريد أن تتحول البلاد إلى دولة تابعة لها، بحسب الباحث التركي أوزكيزيلجيك، موضحا أنها تسعى إلى “تبني نهج مشترك ومنسق مع الدول الإقليمية، لا سيما الدول العربية، وكذلك مع الدول الأوروبية”.
ضياء عودة
الحرة
——————————
من الانتقال السياسي إلى إعادة الإعمار.. معهد ألماني يقيّم سيناريوهات سوريا
ربى خدام الجامع
2025.03.19
قدم معهد الشؤون الدولية والأمنية الألماني* (Stiftung Wissenschaft und Politik)، تحليلاً معمقاً للوضع في سوريا بعد مرور أكثر من ستين عاماً على الديكتاتورية وأكثر من 13 عاماً على بدء الحرب، مع التركيز على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكام الجدد للبلاد.
ويشير التقرير إلى أن سوريا تقف على مفترق طرق حاسم يتطلب معالجة قضايا معقدة تشمل الانتقال السياسي، والمصالحة الاجتماعية، وإعادة الإعمار الشاملة، والتحول الاقتصادي، وعودة اللاجئين والنازحين، بالإضافة إلى حل قضايا أمنية شائكة مثل نزع سلاح الفصائل ودمجها ومحاربة تنظيم الدولة والجماعات المسلحة الأخرى.
تحديات الحكم والسيطرة الإقليمية:
يُسلط التقرير الضوء على أن الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد الشرع لا تسيطر على كامل الأراضي السورية، حيث لا تزال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الغالبية الكردية تسيطر على شمال شرقي سوريا، بينما تواصل تركيا سيطرتها على مناطق عدة في الشمال. وفي الجنوب الغربي، تحتل إسرائيل المنطقة العازلة وهضبة الجولان وجبل الشيخ، وتقيم نقاط تفتيش في المناطق المحيطة. ويستمر التقرير في بيان أن الاشتباكات المسلحة ما تزال دائرة في الشمال والشمال الشرقي بين الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً وقسد المتحالفة مع واشنطن.
يذكر المعهد أن الحكومة المؤقتة اتخذت خطوات لتسريح معظم جيش النظام المخلوع ومحاولة حل الفصائل ودمجهم في الجيش السوري الجديد، بما في ذلك قسد وفاصائل درزية. ومع ذلك، شهدت سوريا أعمال عنف طائفية عقب تمرد فلول للأسد، مما أسفر عن مقتل المئات وأكد على وجود ما سماه “عقيدة طائفية” وعدم انضباط في القوى الأمنية الجديدة، وهو ما يهدد عملية المصالحة.
التقدم السياسي المتعثر:
يشير التقرير إلى أن الإدارة الجديدة مضت قدماً في عملية الانتقال السياسي بتنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقالياً وتأكيده على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة وطناً للجميع. وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي جمع نحو 900 سوري لوضع إطار للعملية الدستورية. وفي بداية آذار، شُكلت لجنة لصياغة دستور مؤقت، وفي 13 آذار، وقع الشرع على إعلان دستوري يمتد لخمس سنوات، يحدد الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ويطرح مبادئ فصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة وحرية التعبير. ومع ذلك، أثار الإعلان الدستوري انتقادات من مختلف الطوائف بسبب عدم تعبيره عن التنوع العرقي والديني لسوريا والإبقاء على تسمية “الجمهورية العربية السورية” وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة واشتراط أن يكون الرئيس مسلماً. ويؤكد التقرير على أن تحقيق توازن بين توقعات التنوع ومواقف الجهات الفاعلة المختلفة يمثل تحدياً كبيراً.
يُوضح التقرير أن القيادة السورية الجديدة تسعى لإعادة تموضع سوريا على المستويين الإقليمي والعالمي بهدف كسر العزلة وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار والحصول على دعم لإعادة الإعمار. وقد تواصل الشرع مع دول الخليج والدول الغربية، وهنأ ترامب على عودته إلى البيت الأبيض، معبراً عن أمله في إحلال السلام واقترح مناقشات مبكرة مع واشنطن. وفي حين حافظ على مسافة بعيدة عن إيران، أكد على أهمية العلاقات الطيبة مع روسيا وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، مؤكداً على التزام دمشق باتفاقيات وقف إطلاق النار وعزمها على حل النزاعات سلمياً، مع توقع علاقات ودية مع تركيا بشكل خاص.
مصالح الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية:
يُفصل التقرير مصالح وأولويات وممارسات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وتأثيرها على عملية الانتقال في سوريا.
تركيا: تسعى إلى محاربة سوريا لإرهاب (حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة)، والحفاظ على تنوعها العرقي والديني وإشراك جميع الأطراف في الحكم، وترغب في لعب دور فاعل في بناء سوريا قوية وموحدة بما يخدم مصالحها. تركز على مصالحها الأمنية وعرضت دعم إصلاح القطاع الأمني، وتسعى للتعاون مع سوريا والأردن والعراق لمحاربة تنظيم الدولة. كما دعت تركيا مقاتلي الفصائل السورية المتحالفة معها في الشمال للانضمام إلى الجيش السوري الجديد بهدف نزع سلاح قسد أو دمج عناصرها في الجيش السوري. وقد خلق إعلان عبد الله أوجلان عن حل تنظيمه أفقاً لتسوية بين تركيا وقسد، وتسعى تركيا لتعزيز التقارب بين قسد والمجلس الوطني الكردي. كما ترغب تركيا في لعب دور بارز في إعادة إعمار سوريا.
دول الخليج (قطر والسعودية والإمارات): يُشير التقرير إلى أن قطر قد تلعب دوراً مهماً في السياسة السورية وكانت أول دولة تزور دمشق بعد سقوط الأسد وتعهدت بدعم إعادة الإعمار. أما السعودية، فيبدو أنها منفتحة على تحقيق انفراجة وترغب في منع سوريا من الاعتماد بشكل كبير على قطر وتركيا. بينما من المحتمل أن تبقى الإمارات على هامش التطورات بسبب معارضتها لهيئة تحرير الشام، لكنها قد تجدد علاقاتها مع دمشق إذا تبين عدم وجود أساس لمخاوفها.
روسيا: غيرت سياستها من دعم نظام الأسد إلى محاولة السيطرة على الأضرار واستعادة نفوذها لتأمين مصالحها، وعرضت التعاون مع القيادة الجديدة. وقد صنفت هيئة تحرير الشام سابقاً كتنظيم إرهابي ثم وصفتها بـ”المعارضة السورية المسلحة” ثم “السلطات الجديدة”. ومع ذلك، قد تواجه روسيا صعوبة في تطبيع العلاقات بسبب مطالب دمشق بتسليم الأسد وجبر الضرر. وقد تراجعت قدرة روسيا على رسم شكل عملية الانتقال، لكنها ما تزال تحتفظ ببعض النفوذ السياسي وتأمل في أن يعوض وجودها العسكري والسياسي المتضائل تعاظم النفوذ التركي. وقد دعت روسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن وحذرت من صعود الحركة الجهادية وشبهت قتل العلويين والمسيحيين بالإبادة في رواندا، مما يدل على استعدادها لاستغلال أي توتر لمصلحتها.
إسرائيل: يهمها أمنها القومي أكثر من العملية الانتقالية أو النظام السياسي الجديد، وتشعر بالقلق إزاء الخلفية المتطرفة للحكام الجدد وتعزز النفوذ التركي. وتضغط على الولايات المتحدة لضمان سلامة القواعد الروسية وتفضل بقاء سوريا دولة لامركزية ضعيفة. كما أعلنت عزمها على الاحتفاظ بوجودها العسكري في سوريا وسعت لتمتين علاقاتها مع الطائفة الدرزية والأكراد وهددت بالتدخل العسكري دعماً للدروز.
الولايات المتحدة: لم تتضح بعد سياسة إدارة ترامب الثانية تجاه سوريا، لكنها تركز على مصالحها الأمنية والجيوسياسية وضمان عدم تحول سوريا إلى “مصدر للإرهاب الدولي” وأمن إسرائيل. وقد أثر قرار تعليق المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتاً على المخيمات ومبادرات المجتمع المدني.
إيران: خسرت نفوذها المباشر وتسعى للتواصل مع الحكومة المؤقتة، لكن دمشق لم تبد اهتماماً كبيراً بإعادة العلاقات. ومن السيناريوهات المطروحة لاحتفاظ إيران بنفوذها استغلال التوترات الطائفية أو تمتين علاقاتها مع قسد أو إعادة تعريف دورها عبر “المقاومة” المناهضة لإسرائيل وظهور جماعة “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا”.
نتائج وخيارات سياسية مقترحة من المعهد الألماني:
يُشدد التقرير على أن لألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في استقرار سوريا ويجب عليهم اقتناص الفرصة والمساهمة في ذلك بتنسيق نهجهم ضمن إطار متعدد الأطراف والتعاون مع الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج. ويدعو إلى مراقبة ودعم تطبيق إعلان حل حزب العمال الكردستاني والاتفاق بين الحكومة المؤقتة وقسد. كما يرى ضرورة العمل على تجديد التزام إسرائيل والحكومة السورية الجديدة باتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974 وتسهيل التواصل بينهما.
ويؤكد التقرير على أهمية تمهيد السبيل لزيادة المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات الأوروبية خطوة أولى ضرورية لكنها غير كافية، ويجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الضغط على واشنطن لرفع العقوبات الأميركية أو إيجاد آليات بديلة لدعم التعافي. ويشدد على ضرورة بقاء العقوبات على كبار الشخصيات التابعة للنظام السابق وهيئة تحرير الشام حتى تلتزم بشروط واضحة مثل الابتعاد عن الحركة الجهادية ومنع العنف الطائفي والتحقيق في المجازر واحترام حقوق الإنسان.
كما يحذر التقرير من الدفع نحو إعادة سريعة للاجئين السوريين ويدعو إلى تمكينهم من المساهمة في إعادة الإعمار من الخارج. ويؤكد على مسؤولية الجيش السوري الجديد في محاربة تنظيم الدولة وضرورة معالجة مشكلة السجون والمخيمات، مع تشجيع الولايات المتحدة على مواصلة دعم جهود مكافحة التنظيم.
أخيراً، يدعو التقرير ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى دعم تشكيل حكومة جامعة وصياغة دستور دائم يعكس تنوع سوريا العرقي والديني لمنع إيران من استغلال التوترات الطائفية وتحقيق مصالحة اجتماعية وسياسية في البلاد.
في الآتي ترجمة تلفزيون سوريا الكاملة للتقرير:
بعد مرور أكثر من ستين عاماً على الديكتاتورية في سوريا وأكثر من 13 عاماً على بدء الحرب التي تدخلت فيها أطراف دولية، أصبح حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات كبيرة، تتمثل بالانتقال السياسي والمصالحة الاجتماعية وإعادة الإعمار الشاملة، والتحول الاقتصادي، وإعادة اللاجئين والنازحين، إلى جانب حل قضايا أمنية شائكة تشمل نزع سلاح الفصائل ومن ثم إدماجها ضمن الهيكلية المعدلة للجيش ومحاربة تنظيم الدولة في حال عودته إلى جانب محاربة المسلحين من الموالين للأسد. وهنالك قضية أخرى تتمثل بأسلوب التعامل مع كل من مقاتلي تنظيم الدولة (وأهاليهم) المحتجزين في مخيمات ومراكز احتجاز تديرها قسد، والمقاتلين الأجانب المنضوين تحت صفوف هيئة تحرير الشام ومن والاها من الفصائل.
والأصعب من ذلك هو أن الحكومة المؤقتة التي يترأسها أحمد الشرع لا تسيطر على كامل التراب السوري، لأن قسد ذات الغالبية الكردية ماتزال تمارس سيطرتها على شمال شرقي سوريا، في حين تواصل تركيا سيطرتها على مناطق عدة في الشمال السوري. وفي جنوب غربي البلد، احتلت إسرائيل المنطقة العازلة التي أقيمت في عام 1974 وكانت في السابق تخضع لسيطرة أممية، إلى جانب احتلالها لجبل الشيخ منذ كانون الأول لعام 2024، كما أنها أقامت نقاط تفتيش لها في المناطق المحيطة بتلك الأراضي. وفي تلك الأثناء، ماتزال الاشتباكات المسلحة دائرة في الشمال وشمال شرقي سوريا ما بين الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً وقسد المتحالفة مع واشنطن في حربها ضد تنظيم الدولة.
الخطوات الأولى للعملية الانتقالية
قامت الحكومة المؤقتة بإجراءات لتسريح معظم عناصر جيش النظام البائد وحل الفصائل ثم دمجهم في الجيش السوري الجديد، وتضم تلك الفصائل قسد والفصائل الدرزية التابعة لغرفة عمليات الجنوب التي وقعت دمشق معها اتفاقيات خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار عقب حدوث أعنف أحداث طائفية في سوريا منذ سقوط النظام. إذ بعد ظهور تمرد موال للأسد ضد قوات الأمن الجديدة، قتل أكثر من ثمانمئة سوري معظمهم من الطائفة العلوية، بعضهم في اشتباكات وبعضهم الآخر في عمليات القتل الانتقامية التي أعقبتها والتي نفذت بحق من قُبض عليهم من العساكر والمدنيين، وهذه التطورات أكدت وجود عقيدة طائفية سائدة، إلى جانب عدم الالتزام بالانضباط وعدم وجود هياكل قيادة واضحة ضمن القوى الأمنية الجديدة، ما يشكل خطراً حقيقياً يهدد عملية المصالحة بين الطوائف العرقية والدينية في سوريا. وحتى قبل موجة العنف الأخيرة، ظهرت تقارير حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان نفذتها قوات الأمن الجديدة بحق أفراد من نظام الأسد المخلوع، ومعظم تلك الانتهاكات نفذت كأعمال انتقامية بحق العلويين.
مضت الإدارة الجديدة بعملية الانتقال السياسي نحو الأمام، إذ في أواخر شهر كانون الثاني من عام 2025، وبعد أن تم تنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقالياً على يد من انتصروا من الثوار، شدد هذا الرجل على ضرورة أن تصبح سوريا الجديدة وطناً لكل مواطنيها تختفي فيه كل أعمال الانتقام، وأكد على أهمية تشكيل حكومة جامعة تكفل تمثيل الجميع في مطلع شهر آذار. وفي أواسط شهر شباط، شكل الشرع لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بينهم ممثلون عن “حكومة الإنقاذ” السابقة في إدلب وعضوان من المجتمع المدني، ثم انعقد هذا المؤتمر الذي لم تسبقه فترة إشعار مناسبة، خلال الفترة ما بين 24-25 من شباط في دمشق، وجمع نحو 900 سوري من أجل وضع إطار العمل الميداني تمهيداً للمضي قدماً بالعملية الدستورية. وفي بداية شهر آذار، شكلت لجنة لصياغة دستور مؤقت، لكن الأمور لم تخضع لمداولة كبيرة، إذ بحلول الثالث عشر من آذار، وقع الشرع على إعلان دستوري يمتد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وحددت تلك الوثيقة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وطرحت مبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة أمام القانون وحرية التعبير. بيد أن مسؤولية التشريع خلال الفترة الانتقالية، ستكون بيد البرلمان الذي سيجري تعيين أعضائه (على أن يعين الرئيس وبشكل مباشر ثلث أعضائه)، أما الرئيس فيتمتع بسلطات تنفيذية وبيده أمر الإعلان عن حالة الطوارئ. كما سيجري تشكيل لجنة من أجل العدالة الانتقالية، إلى جانب لجنة لصياغة دستور دائم للبلد، وسيجري تأجيل الانتخابات حتى عام 2030. وسرعان ما أثار الإعلان الدستوري انتقادات من الطوائف في سوريا، إذ على الرغم من طرحه لمبدأ حرية الدين والمعتقد، لم يعبر عن التنوع العرقي والديني لسوريا التي احتفظت باسمها السابق (الجمهورية العربية السورية)، إلى جانب تسمية العربية وحدها كلغة رسمية للبلد، والتأكيد على وجوب أن يكون الرئيس مسلماً، ولكن لا شك بأن خلق حالة توازن بين توقعات التعبير عن التنوع بين الأغلبية والأقليات، وناشطي المجتمع المدني والعديد من الجهات الأجنبية الداعمة والفصائل المتطرفة الموجودة ضمن قاعدة القيادة الانتقالية نفسها يعتبر أمراً محفوفاً بالمخاطر والتحديات إلى أبعد الحدود.
وفي الوقت ذاته، تحرص القيادة السورية الجديدة على إعادة تموضع سوريا بعد سقوط الأسد على المستويين الإقليمي والعالمي، والهدف من ذلك كسر العزلة التي فرضت على البلد لفترة طويلة، وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار، إذ تريد سوريا الجديدة أن تتجنب تلك النظرة التي تعتبرها تهديداً على المستوى الإقليمي أو الدولي، والأولوية الأساسية في هذا السياق الحصول على الدعم من أجل إعادة إعمار البلد، ولتحقيق هذه الغاية، لم يمد الشرع يده لدول الخليج العربية فحسب، وعلى رأسها السعودية، بل للدول الغربية أيضاً، إذ هنأ دونالد ترامب على عودته الأخيرة إلى البيت الأبيض، وأعرب عن أمله بأن يعمل الرئيس الأميركي على إحلال السلام، واقترح قيام مناقشات مبكرة مع الإدارة الجديدة بواشنطن. وفي الوقت الذي احتفظ الشرع بمسافة بعيداً عن إيران، أكد مصلحته في المحافظة على علاقات طيبة مع روسيا، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، وأكد على التزام دمشق باتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة في عام 1974 وعلى عزمها على حل النزاعات مع دول الجوار بطريقة سلمية، والجميع يتوقع قيام علاقات ودية وتقارب مع تركيا على وجه الخصوص.
مصالح الجهات الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في سوريا
إن مصالح الجهات الفاعلة إقليمياً ودولياً وأولوياتها وممارساتها هي التي ستهيئ الساحة أمام حكام سوريا الجدد في تعاملهم مع التحديات التي تكتنف العملية الانتقالية بسوريا، إذ عقب سقوط نظام الأسد، عمدت بعض تلك الجهات الفاعلة الخارجية إلى تغيير موقفها، في حين أوضحت أطراف أخرى، مثل الولايات المتحدة، موقفها تماماً. بيد أن هنالك شيئاً واضحاً يهمهم جميعاً بالمقام الأول، ألا وهو المصالح القومية إلى جانب مراعاة الاعتبارات السياسية والاقتصادية الداخلية، وهذا ما يؤكد احتمال ظهور تضارب قد يعيق الجهود الساعية لتحقيق الاستقرار في سوريا.
تركيا
تشير التصريحات الرسمية الصادرة عن تركيا إلى وجود ثلاثة أهداف لديها في سوريا، أولها ضرورة عدم دعم سوريا للإرهاب (والمقصود هنا حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة) وعدم تشكيلها لأي خطر يهدد جيرانها، إلى جانب احتفاظها بتنوعها العرقي والديني وضرورة تمثيل وإشراك كل تلك الأطراف في الحكم. أي أن أنقرة تعتبر عملية نشر الاستقرار التي تقوم بها الحكومة المؤقتة الموجودة في دمشق ضرورة، وترغب في لعب دور فاعل في بناء سوريا القوية والموحدة، وبما ينسجم مع المصالح التركية الأساسية، ولهذا تسعى تركيا للانخراط في مجالين مهمين على المدى القصير والمتوسط.
أولاً: تركز تركيا على مصالحها الأمنية، ولهذا عرضت فكرة دعم عملية إصلاح القطاع الأمني في سوريا، وبحسب ما ذكره وزير الدفاع التركي يشار غولار، فإن أنقرة على استعداد لمساعدة الحكومة الانتقالية في التدريب العسكري إن لزم الأمر. وفي مطلع شهر شباط، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الشرع في أنقرة لمناقشة التعاون الوثيق في مجالات عدة، أبرزها احتمال توقيع معاهدة دفاع بينهما. كما تسعى كل من تركيا وسوريا والأردن والعراق لمحاربة تنظيم الدولة معاً، إذ عقد أول اجتماع للتباحث في هذا الشأن بالأردن في التاسع من آذار، من دون أن يعلن عن أي خريطة ملموسة للطريق في هذا الاتجاه.
في تلك الأثناء، دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، جميع مقاتلي الفصائل السورية الموجودة في شمالي سوريا والمتحالفة مع تركيا، والتي تضم أكثر من 80 ألف مقاتل إلى الانضمام إلى الجيش السوري الجديد. وهذه الدعوة تتماشى مع الاستراتيجية الأوسع لأنقرة الساعية إلى نزع سلاح قسد الذي تترأسه وحدات حماية الشعب الكردية، أو العمل على إدماج العساكر الأفراد ضمن جيش البلد الذي يخضع لقيادة دمشق بشكل كامل. كما تهدف دعوته أيضاً إلى طرد أي عناصر تركية (وغير سورية) موجودة ضمن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب من سوريا، ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت تركيا خطوات عسكرية من خلال الجيش الوطني السوري، كما استعانت بدعمها الجوي لقطع خطوط الإمداد عن قسد والموجودة في محيط عين العرب كوباني بالشمال السوري، فأضعفت بذلك القدرات القتالية لدى تلك المجموعة.
وفي الوقت ذاته، تمارس تركيا ضغطاً دبلوماسياً على قسد وحزب العمال، إذ في أواخر شباط الماضي، أعلن عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال المسجون في تركيا، عن حل تنظيمه ونزع سلاحه بكل ثقة، ما دفع بحزب العمال إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار والتصديق على ما أعلنه أوجلان والمطالبة بإطلاق سراحه. وهذا ما جعل الجهات الفاعلة الكردية في العراق، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ترحب بمبادرة أوجلان، ومن جانبه، أوضح القائد الأعلى لقسد، مظلوم عبدي، بأن حل الحزب ورمي سلاحه لا يمكن تطبيقه على قسد، لكنه أعرب عن انفتاحه على أي حل سلمي في سوريا.
خلق إعلان أوجلان أفقاً لتحقيق تسوية ما بين تركيا وقسد، وإزاء ذلك ظهر بين ثنايا إصرار أنقرة على ضرورة أن تكون سوريا شاملة وجامعة لكل الطوائف العرقية والدينية احتمال تأويل ذلك كبادرة على التفاوض من أجل تشكيل هيئة تمثيلية جديدة للكرد، إذ بالفعل، سعت تركيا منذ أمد بعيد لتعزيز التقارب بين قسد والمجلس الوطني الكردي الذي دعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، وفي مكالمة هاتفية مع عبدي، أعلن مسعود برزاني زعيم هذا الحزب عن دعمه للاتفاق الحاصل مؤخراً بين دمشق وقسد، وأكد على أهمية وحدة الكرد، كما رحب المسؤولون الأتراك بهذه الاتفاقية بحذر، وأكدوا على ضرورة تطبيقها بشكل كامل، وفي هذه الأثناء تواصلت الغارات الجوية التركية على العراق وسوريا.
أما المجال المهم الثاني الذي ترغب القيادة التركية في لعب دور بارز من خلاله فهو إعادة إعمار سوريا، إذ بعيداً عن الفرص الاقتصادية التي يرجح لشركات البناء التركية أن تقتنصها، يمكن لذلك أن يعزز شعبية أردوغان وسط حالة الضيق الاقتصادية التي تعيشها تركيا، كما أن أنقرة تعتبر إعادة إعمار سوريا شرطاً مهماً لتسهيل عودة اللاجئين السوريين.
دول الخليج
إذا نجحت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها في تعزيز موقفها، فإن قطر ستلعب دوراً مهماً في السياسة السورية هي أيضاً، إذ ليست مصادفة تلك التي جعلت من الأمير تميم بن حمد أول قائد دولة يزور دمشق بعد سقوط الأسد. ومنذ ذلك الحين، توالت زيارات المسؤولين والوفود القطرية على سوريا وذلك خلال شهري كانون الأول من عام 2024 وكانون الثاني عام 2025. وفي أواسط كانون الأول، كانت السفارة القطرية ثاني سفارة تعيد فتح أبوابها، بعد السفارة التركية، عقب تعليق العلاقات الدبلوماسية الذي نفذته دول كثيرة بين عامي 2011-2012 رداً على قمع النظام البائد للمعارضة. وتعهد رئيس وزراء قطر بدعم عملية إعادة إعمار سوريا وطالب بإنهاء العقوبات المفروضة عليها، إذ من الواضح تماماً بأن الدوحة قد وضعت نفسها في موضع أحد الوسطاء المهمين بين سوريا وأي دولة ثالثة، وستتعاظم أهمية هذا الدور في حال بقيت تلك الدول مترددة في التعامل مع الحكام الجدد لدمشق.
ثمة دولة أخرى بوسعها لعب دور مهم في المشهد الدبلوماسي السوري وهذه الدولة هي السعودية، إذ يبدو بأن هنالك مصلحة كبيرة لهيئة تحرير الشام في تعزيز علاقات طيبة مع أقوى دولة عربية، وقد ألمحت المملكة إلى انفتاحها على تحقيق انفراجة وذلك عندما أرسلت وزير خارجيتها الذي دعا على الفور إلى رفع العقوبات وقدم الدعم للحكومة الجديدة. ويبدو أن الرياض مستعدة للاعتراف بالواقع الجديد في دمشق مع التشجيع على الحوار والتعاون لإدارة النتائج المترتبة على سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة. وثمة شيء مهم لا بد أن تأخذه السعودية بالحسبان وهو منع سوريا من الاعتماد بشكل كبير على قطر وتركيا، غير أن قيام الشرع في مطلع شباط 2025 بأول زيارة خارجية له عقب سقوط الأسد إلى الرياض بدلاً من أنقرة يوحي باحتمال الابتعاد عن هذا الشكل من الاعتماد الكبير.
يحتمل للإمارات أن تبقى على هامش كل تلك التطورات نظراً لوقوفها ضد هيئة تحرير الشام ومعارضتها لها بشكل مبدئي وهذا ما يمنعها من التعامل معها مباشرة، لهذا يرجح لأبوظبي أن تراقب من كثب احتمال إثارة انتصار الإسلاميين في سوريا لمزيد من الاضطرابات في المنطقة، ولهذا لن تألو جهداً في منع وصول آثار ذلك إلى بلادها. ولكن إن تبين لها عدم وجود أصل أو أساس لمخاوفها، فإن الإمارات ستكون من بين تلك الدول التي ستحرص على تجديد علاقاتها مع دمشق.
روسيا
بما أنها كانت من أهم داعمي نظام الأسد في السابق، فقد غير الكرملين سياسته وانتقل إلى سياسة السيطرة على الأضرار مع سعيه في الوقت ذاته لاستعادة نفوذه السياسي من أجل تأمين مصالحه الأساسية في سوريا، وخاصة فيما يتصل بالاستعانة بالقواعد العسكرية الموجودة فيها، ولهذا عرضت روسيا التعاون مع القيادة الجديدة في دمشق لأنها ترغب أن تقدم نفسها كعنصر فاعل براغماتي على استعداد للتكيف مع ديناميات السلطة الجديدة. إذ حتى كانون الأول من عام 2024، بقيت موسكو تصنف هيئة تحرير الشام على أنها تنظيم إرهابي، ولكن في الثامن من كانون الأول 2024، أي في يوم سقوط الأسد، صارت تصف الهيئة بأنها “المعارضة السورية المسلحة” ثم أصبحت تصفها بـ”السلطات الجديدة”. وفي محاولة للتعامل مع الهيئة، أعلن فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة بأن التحالف الروسي مع سوريا “لا يرتبط بأي نظام”.
غير أن موسكو قد تكتشف صعوبة “تطبيع” العلاقات مع الحكومة التي تترأسها هيئة تحرير الشام، وهذا ما اتضح عندما زار نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سوريا في أواخر شهر كانون الثاني من عام 2025، إذ خلال تلك الزيارة، أوضح الشرع بأن على روسيا الاعتراف بما وصفه “أخطاءها السابقة” من أجل “إعادة بناء الثقة”، بيد أن هنالك مطلبين تقدمت بهما دمشق من المرجح أن يمثلا تهديداً حقيقياً لموسكو، خاصة في ظل ظروف الحرب المستمرة في أوكرانيا، وهذان المطلبان هما: تسليم الأسد وجبر الضرر، إذ لا أحد يتوقع أن تسلم روسيا الأسد على الإطلاق، بما أن تسليمه لا بد أن يقوض مصداقية روسيا بوصفها حامياً موثوقاً لحلفائها من المستبدين، أما فيما يتصل بالمطلب الثاني، فإن موسكو قد تعفي سوريا من قسم من ديونها الكبيرة المستحقة لروسيا، أو قد تعفيها منها كلها، أو قد تمدها بالحبوب أو النفط من دون أن تعترف رسمياً بما يُلزمها بتقديم تعويضات بهدف جبر الضرر. وفي تلك الأثناء، وفي محاولة منها لتحسين صورتها، قدمت روسيا اللجوء للسوريين الهاربين من العنف الطائفي الذي اندلع في آذار، وعرضت الاستعانة بقواعدها العسكرية كمراكز لوجستية لتوزيع المساعدات الإنسانية، ومن جانبها، ستبقى القوات المسلحة السورية معتمدة على روسيا في عمليات الصيانة وتأمين قطع التبديل في المستقبل المنظور.
لا شك أن قدرة روسيا على رسم شكل عملية الانتقال في سوريا قد تراجعت بشكل كبير، إذ لم يعد لدى روسيا حلفاء سياسيون أقوياء في سوريا، كما تراجعت إمكاناتها العسكرية على حماية هؤلاء الحلفاء، والأهم من كل ذلك أن عملية أستانا التي نسقت من خلالها روسيا وتركيا وإيران مواقعها تجاه مستقبل سوريا، لم يعد لديها أي نفوذ أو أهمية، ومع ذلك ما تزال موسكو تحتفظ ببعض النفوذ السياسي في سوريا، إذ يأمل الكرملين أن يتحول استمرار الوجود العسكري والسياسي على الرغم من تقلصه في سوريا نفسها وفي المنطقة كلها إلى مصلحة استراتيجية للحكومة الانتقالية، بما أن هذا الوجود سيقف ضد تعاظم الوجود والنفوذ التركي في سوريا. وبما أن روسيا تعتبر دولة قوية تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن وبما أنها عنصر فاعل مهم في المنتديات الدولية مثل دول البريكس+ والتجمعات الإقليمية مثل مجلس شنغهاي للتعاون، فإنه بوسع روسيا إما أن تسهم أو أن تعقد عملية تحقيق الاعتراف الدولي بالقيادة السورية الجديدة.
ونظراً لاحتمال التقارب بين روسيا والولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، ومطالبة إسرائيل بإبقاء القواعد الروسية في سوريا، والمجازر التي قامت ضد العلويين والمسيحيين في سوريا في آذار 2025، بات من الواضح أن الكرملين تعجبه الشروط التي تساعده على تعزيز موقفه ومكانة بلده، إذ إلى جانب الولايات المتحدة، دعت روسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن في منتصف شهر آذار حذر خلاله المندوب الروسي من صعود الحركة الجهادية في سوريا، وشبه قتل العلويين والمسيحيين بالإبادة التي حصلت في رواندا. ثم إن انعقاد الاجتماع خلف أبواب موصدة دليل على أن روسيا لا تريد أن تخاطر بعلاقتها التي ما تزال هشة مع القيادة الجديدة في سوريا، وفي الوقت عينه، يظهر ذلك استعداد روسيا الدائم لاستغلال أي توتر في سوريا لمصلحتها حتى تمارس الضغط عبر التلاعب ضمنياً بفكرة تأييد قيام حكم ذاتي في المنطقة الغربية من سوريا، بيد أن تصريح الشرع بأنه يرغب في الاحتفاظ بـ”علاقات استراتيجية عميقة” مع روسيا، وضرورة عدم وجود أي “شقاق بين سوريا وروسيا” يعتبر مؤشراً على نجاح سياسة الحد من الأضرار التي تنتهجها موسكو.
إسرائيل
في الوقت الذي تدعم المؤسسة السياسية الإسرائيلية عموماً “حق استقلال” الأقليات العرقية والدينية عن سوريا، ما يزال أشد ما يقلقها من جارتها هو أمنها القومي لا العملية الانتقالية ولا النظام السياسي الجديد فيها. إلا أن خلفية حكام دمشق الجدد تعتبر مصدراً للقلق بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة لتعاظم النفوذ التركي بما أن إسرائيل تعتبر تركيا عدوة، وبحسب تقارير ظهرت عبر الإعلام، فإن إسرائيل تضغط بشكل فاعل على الولايات المتحدة لضمان سلامة القواعد العسكرية الروسية الموجودة في سوريا، لأنها تفضل بقاء روسيا في وجه تركيا، كما تتمنى لسوريا أن تظل دولة لامركزية ضعيفة.
هذا ولم تكتف إسرائيل بالإعلان عن عزمها على الاحتفاظ بوجودها العسكري في سوريا في المستقبل المنظور، بل سعت أيضاً إلى تمتين علاقاتها مع الطائفة المقيمة في المنطقة الحدودية ومع الكرد أيضاً، إذ بنهاية شهر شباط عام 2025، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع كامل للمظاهر العسكرية من ثلاث محافظات سورية تقع في الجنوب، وهي القنيطرة ودرعا والسويداء، وأعلن أن إسرائيل لن تتسامح مع أي وجود للجيش السوري في تلك المناطق، وفي بداية شهر آذار، وفي ظل الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين قوات الأمن التابعين للحكام الجدد والفصائل الدرزية الموجودة في ضاحية جرمانا القريبة من دمشق، هددت إسرائيل بتدخل عسكري دعماً للطائفة الدرزية، وفي أواسط شهر شباط، سمحت لوفد مؤلف من شخصيات دينية درزية بزيارة مواقع دينية وزيارة الطائفة الدرزية المقيمة ضمن الأراضي التي تخضع لسيطرة إسرائيل وذلك لأول مرة منذ حرب عام 1973. كما عرضت إسرائيل على الدروز منحهم مساعدات وفتح فرص العمل أمامهم.
الولايات المتحدة
لم تتضح بعد ملامح المسار الذي ستسير عليه الولاية الثانية لترامب مستقبلاً فيما يخص سوريا، كما أن واشنطن لم تعتبر قيام مناقشات بشأن سوريا أولوية بالنسبة لها، ولكن السياسة الأميركية قد تتغير فجأة، وقد يؤثر ذلك بشكل خاص على الوجود العسكري الأميركي في سوريا وعلى التعاون الأميركي مع قسد، إذ تشير أولى الإرهاصات إلى أن إدارة ترامب لا تركز على “الانتقال الجامع” لأن ما يهمها هو مصالحها الأمنية والجيوسياسية، كما أن أهم أهدافها تتمثل بضمان عدم تحول سوريا إلى “مصدر للإرهاب الدولي” إلى جانب ضمان أمن إسرائيل.
وفي الوقت ذاته، ظهرت تعقيدات عقب القرار الذي أصدرته إدارة ترامب بخصوص تعليق كامل المساعدات الخارجية الأميركية بصورة مؤقتة، والتي تشمل تلك المساعدات التي تقدم للمرافق مثل مراكز الاحتجاز أو المخيمات وعلى رأسها مخيما الهول والروج حيث يحتجز مقاتلو تنظيم الدولة مع عوائلهم. وفي الوقت الذي تم التوصل فيه إلى حل مؤقت لتعويض العناصر الأمنية التي تحرس تلك المقرات، بما أن رواتبهم كانت في السابق تصلهم عبر التمويل المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإن اضطرابات حادة قد تعقب ذلك في حال قطع الحوالات إلى أجل غير مسمى. ولقد أضر تعليق المساعدات الخارجية الأميركية بعمليات المفوضية العليا للاجئين بشكل كبير في سوريا كما أضر بعدد من المبادرات الخاصة بالمجتمع المدني السوري.
إيران
مع سقوط نظام الأسد، خسرت إيران نفوذها المباشر في سوريا، وصارت تحرص اليوم على التواصل مباشرة مع الحكومة المؤقتة في دمشق، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن نهج إيران: “يقوم على سلوك الطرف الآخر”، ملمحاً إلى استعداد طهران لإحياء علاقاتها التي قطعها سقوط الأسد في حال سنحت لها الفرصة. بل حتى المرشد الأعلى، علي خامنئي، غير موقفه العدائي الذي أبداه في البداية تجاه الحكام الجدد لسوريا، فصار يركز الآن على المطالبة بـ”تحرير البلد من الاحتلال الأجنبي”، بيد أن دمشق لم تبد كبير اهتمام بإعادة العلاقات مع طهران، إذ حتى لو جرى إحياء تلك العلاقات، سيظل النفوذ الإيراني أضعف بكثير مما كان عليه من قبل، ونظراً لافتقار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الموارد الاقتصادية التي بوسعها تقديمها كحوافز مهمة، يرجح لدورها أن يبقى محدوداً في سوريا، أما جهود إعادة الإعمار فستقودها جهات فاعلة تتمتع بموارد مالية أكبر تحت تصرفها.
من السيناريوهات المنطقية المطروحة بالنسبة لاحتفاظ إيران بنفوذها ذلك السيناريو الذي يرى بأن ذلك يمكن أن يتم عبر استغلال أي توتر طائفي، إذ يرجح لطهران أن تزيد من تواصلها مع الطائفة العلوية في غربي سوريا، كما يمكن للتقارير التي تتحدث عن اعتقالات وإعدامات طالت العلويين على يد فصائل تابعة لهيئة تحرير الشام أن تغذي أنشطة خلايا المقاومة التي يمكن لإيران أن تدعمها بالسر كوسيلة لممارسة الضغط، بيد أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد وبشكل كبير على طريقة تعامل الحكام الجدد مع العدالة الانتقالية والديناميات الطائفية في سوريا.
وثمة نهج آخر مطروح وهو سعي إيران لتمتين علاقاتها مع قسد، إذ يمكن لتوقع الانسحاب الأميركي من سوريا أن يدفع قسد للبحث عن شراكات أخرى، وبحسب تقارير، فإن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني، أجرى محادثات مع قائد قسد، مظلوم عبدي، في مدينة السليمانية العراقية في مطلع كانون الثاني لعام 2025، وقد قيل إن بافل طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو من سهّل عقد ذلك الاجتماع. بيد أن عقد شراكة مع كرد سوريا لن يسمح لإيران بالاحتفاظ بنفوذها على الديناميات الداخلية لسوريا فحسب، بل بوسعه أيضاً الوقوف ضد النفوذ الإقليمي التركي مع كبح جماح العلاقات المتنامية بين إسرائيل والفصائل الكردية. غير أن الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين الحكومة التي تتزعمها هيئة تحرير الشام وقسد قد يتحول إلى مفتاح للعمل في هذا المضمار، إذ نظراً للشكوك المحيطة بتنفيذ الاتفاقية واحتمال تجدد التوتر بين القوات الكردية السورية من جهة ودمشق وأنقرة من جهة أخرى، يرجح لطهران أن تحافظ على فتح قنوات تواصل مع الكرد.
وأخيراً، قد تسعى طهران لإعادة تعريف دورها في سوريا عبر “المقاومة” المناهضة لإسرائيل، إذ بعد فترة قصيرة من الخطاب الذي ألقاه خامنئي في الثاني والعشرين من كانون الأول عام 2024، ظهرت جماعة لم تكن معروفة سابقاً، لكنها أطلقت على نفسها اليوم اسم: “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا”، وأعلنت أن هدفها هو طرد القوات الإسرائيلية من البلد، وهذا التطور قد يمد إيران بسبل جديدة للاحتفاظ بنفوذها في سوريا، إذ مثلاً، قد تعمد طهران إلى الاعتماد على قوات وكيلة جديدة أو إلى التحجج بـ”مقارعة الاحتلال” لتبرير تعاونها مع الحكومة السورية الجديدة.
نتائج وخيارات سياسية
لدى ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في تأمين عملية نشر الاستقرار في سوريا وضمان عدم تشكيل هذا البلد لأي خطر على جيرانه وعلى أوروبا، لأن سقوط نظام الأسد قدم فرصة فريدة لتحقيق تلك الأهداف، إلا أن احتمال الخطأ ما يزال كبيراً، لأن النزاعات المسلحة قد تشتعل مرة أخرى في سوريا، وبدورها سوف تشجع العناصر الفاعلة الإقليمية والدولية على التدخل عسكرياً من جديد، وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن ذلك سيطيل أمد اقتصاد الحرب والاتجار بالمخدرات، وهذا ما سيدفع لظهور موجات نزوح جديدة، وفي الوقت ذاته، ستظل سوريا ملاذاً آمناً ومقراً لتجنيد العناصر ضمن تنظيم الدولة وغيره من الجماعات الجهادية.
ولهذا ينبغي على ألمانيا والاتحاد الأوروبي اقتناص هذه الفرصة التي ظهرت اليوم للمساهمة في نشر الاستقرار بسوريا، إلى جانب تنسيق نهجها بشكل وثيق ضمن عمل إطاري متعدد الأطراف، ويعتبر التعاون ضرورياً بشكل كبير مع الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ويجب أن ينصب الهدف على وقف تصعيد الخصوم الجيوسياسيين بدلاً من العمل على تأجيج هذا التصعيد، مع دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها على اعتبار ذلك أحد المبادئ الإرشادية ضمن هذا المضمار.
إن الإعلان عن حل حزب العمال الكردستاني من جهة، والاتفاق بين الحكومة السورية المؤقتة وقسد من جهة أخرى، يعتبر فرصة لحل التوتر في الشمال السوري، ولهذا لا بد من مراقبة تطبيق هذين الأمرين من كثب مع دعم العمليتين، وذلك لأن فشل أي منهما يمكن أن ينعكس بالسلب على الأخرى. وفي هذا السياق، من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف المشاركة فيهما، وعلى رأسها رغبة الكرد في الحصول على تمثيل يناسبهم في أي حكومة سورية مستقبلاً وكذلك رغبتهم في الحصول على حكم ذاتي بصلاحيات واسعة، إلى جانب مراعاة المخاوف الأمنية التركية ومصلحة دمشق في حل الفصائل وإنهاء السيطرة التركية على أجزاء من سوريا.
كما يجب على ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي العمل على ضمان تجديد التزام كل من إسرائيل والحكومة السورية الجديدة باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة عام 1974، وهذا من شأنه أن يجبر إسرائيل على سحب قواتها من المنطقة العازلة ومن جبل الشيخ وإعادة المنطقة لسيطرة قوات مراقبة فض الاشتباك الأممية. كما بوسع برلين وغيرها من شركائها الأوروبيين وبالتشاور مع الولايات المتحدة، تسهيل التواصل بين القيادة السورية وإسرائيل للحد من خطر المواجهات العسكرية، بما أن التواصل أضحى ضرورة نظراً لانتهاء العمل بآلية التنسيق الروسية الإسرائيلية لتجنب الصراع في سوريا.
ويجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي تمهيد السبيل أمام زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار سوريا التي دمرتها الحرب بعد سنين طويلة، وإن تحقيق تحسن سريع في الوضع الاقتصادي السوري يعتبر أمراً مهماً لنشر الاستقرار في البلد، إذ في أواخر شهر كانون الثاني، اتخذ مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خطوة في الاتجاه الصحيح عندما صدّق على خريطة طريق من أجل تخفيف العقوبات بشكل تدريجي على القطاعات والمؤسسات في سوريا. وبنهاية شهر شباط، جرى تعليق بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على قطاع الطاقة والنقل والقطاع المالي، على الرغم من أنها لم تُرفع بشكل كامل، إذ تعتبر تلك الإجراءات الأولية ضرورية لكنها ليست كافية، لأن العقوبات الأميركية ما تزال تمثل عائقاً رئيسياً أمام إعادة إعمار سوريا وتعافيها على المستوى الاقتصادي، ولذلك يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يضغطا على واشنطن حتى ترفع تلك العقوبات، وفي حال بقيت تراوح مكانها، عندئذ يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الخروج بآليات قابلة للتطبيق وذلك لدعم المساعدات الإنسانية ولتمهيد الطرق أمام التعافي الأولي للبلد، كما تجب إعادة توجيه الأصول المجمدة لنظام الأسد البائد نحو جهود إعادة الإعمار.
وفي الوقت ذاته، يجب أن تبقى العقوبات المفروضة على كبار الشخصيات التابعة لنظام الأسد وهيئة تحرير الشام، وقبل إخراج الهيئة من لوائح الإرهاب في ألمانيا والاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات عمن يمثلوها، لا بد لهم من تحقيق شروط واضحة، إذ يجب على حكام دمشق الجدد أن يظهروا ابتعادهم بشكل حقيقي عن الحركة الجهادية، وذلك عبر تعزيز العلاقات الخارجية بشكل سلمي مثلاً، أو عبر منع قيام عنف على أساس طائفي، وفتح تحقيق في المجازر التي ارتكبت في آذار 2025 ومحاكمة مرتكبيها، والالتزام بإقامة عدالة انتقالية شفافة، واحترام لحقوق الإنسان.
ومن جانبهما، يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يحجما عن الدفع نحو إعادة سريعة للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا حالياً، إذ لا يكفي الالتزام بمبدأ العودة الطوعية الآمنة والكريمة، بل أيضاً يجب أن يحل في سوريا ما يكفي من الاستقرار حتى تصبح جاهزة لعودة مواطنيها. ويجب على السياسة الأوروبية أن تولي الأولوية لتمكين اللاجئين على الإسهام بطريقة بناءة ودائمة في إعادة أعمار سوريا، بما أن هذه المساهمة يمكن أن تتم من الخارج. وفي الوقت عينه، ينبغي على ألمانيا دعم مفوضية اللاجئين في تسهيل عمليات العودة الطوعية، وهنا تظهر الحاجة لظهور حل وسط ما بين مصلحة ألمانيا في نشر الاستقرار بسوريا ومصلحتها في قدرتها على ترحيل الإرهابيين والمجرمين على وجه الخصوص، إلى جانب قدرتها على ترحيل السوريين الذين لا يندرجون ضمن هاتين الفئتين.
هذا ويجب على جيش سوريا الجديدة أن يتولى مسؤولية محاربة تنظيم الدولة، بما أنه التزم بذلك من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تركيا والعراق والأردن في مطلع شباط الماضي. أما مستقبلاً، فلا بد من مراعاة دور سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وفي تلك الأثناء، سيتعين على دمشق معالجة مشكلة السجون والمخيمات التي احتجز فيها مقاتلو التنظيم مع عوائلهم. ويجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي تشجيع الولايات المتحدة على مواصلة دعمها لمحاربة تنظيم الدولة وتمويل مقار الاحتجاز، وفي الوقت ذاته، يجب على الدول الأوروبية أن تحرص على إجلاء مقاتلي تنظيم الدولة الذين يحملون جنسيات أوروبية حتى تجري محاكمتهم في أوطانهم.
وأخيراً، يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي دعم تشكيل حكومة جامعة قائمة على المشاركة بشكل فاعل وصياغة دستور دائم لسوريا يعكس تنوعها العرقي والديني، لأن ذلك لا يعتبر ضرورياً فحسب من أجل نجاح العملية مستقبلاً، بل أيضاً لمنع إيران من استغلال أي توتر طائفي أو عرقي لمد نفوذها في سوريا، ولهذا السبب وغيره، يجب أن تكون الأولوية المركزية لأوروبا منصبة على الإسهام بإقامة مصالحة اجتماعية وسياسية في سوريا.
* Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) هو المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهو مركز أبحاث مستقل مقره في برلين، ألمانيا. يُعتبر من أبرز مراكز الأبحاث والاستشارات السياسية في أوروبا، ويُقدّم تحليلات ودراسات للحكومة الألمانية والبرلمان (البوندستاغ) حول القضايا الدولية والأمنية.
المصدر: Stiftung Wissenschaft und Politik
تلفزيون سوريا
——————————–
سوريا إلى أين؟/ بكر صدقي
تحديث 21 أذار 2025
من واكب التطورات السياسية في سوريا ما بعد نظام الأسد لا يخفى عليه تخبط المجموعة الحاكمة الجديدة أمام التحديات الهائلة التي خلّفها النظام المخلوع. بات وراءنا الآن أكثر من ثلاثة أشهر لم تسجل خلالها الإدارة الجديدة أي تقدم في أهم الملفات كالأمن والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي وتفكيك الفصائل المسلحة وتوحيد الجغرافيا السورية والمجتمع السوري.
لقد انبهرت هذه السلطة بسرعة توليها السلطة في اثني عشر يوماً، وبالقبول العربي والإقليمي والدولي الواسع والسريع بها، كما بقبول غالبية اجتماعية قام قبولها على الالتفاف حول الإنجاز الكبير المتمثل في إسقاط النظام. وفي حين تدين السلطة لسرعة إسقاط النظام بظرف إقليمي استثنائي هو ارتدادات عملية «طوفان الأقصى» وتداعياتها الكارثية، قام القبول العربي ـ الإقليمي ـ الدولي على رغبة الدول المعنية باستعادة الاستقرار الذي طال غيابه 14 عاماً وتسبب بتداعيات خطيرة وصلت آثارها إليها، كمشكلات الإرهاب وتدفق اللاجئين والمخدرات والأعباء الاقتصادية المرتبطة بها. أما القبول السوري العام فكان أساسه الفرح العارم بسقوط النظام وما عناه ذلك من انفتاح الأفق أمام تأسيس جديد يقطع مع الماضي الكارثي، إضافة إلى الأداء المقبول لهيئة تحرير الشام وحلفائها أثناء عملية «ردع العدوان» وبخاصة في مناطق حساسة كحلب ودمشق وجبال الساحل، حيث لم تشهد المعركة عمليات انتقامية واسعة النطاق أو أعمال عنف على أساس طائفي أو تضييقاً واسع النطاق على الحريات العامة والخاصة.
غير أن كل ذلك راح ينقلب إلى تراجع في شعبية الفريق الحاكم بمرور الأيام، بدءاً بمسرحية «مؤتمر الحوار الوطني» الهزلية وصولاً إلى المجازر الطائفية في الساحل مع الأسبوع الأول من شهر آذار الجاري، وأخيراً إصدار الإعلان الدستوري الذي لاقى انتقادات واسعة، فطغى على المشهد السياسي غياب الثقة بين قطاعات واسعة من المجتمع لا تقتصر على العلويين أو الأقليات، مقابل ارتفاع منسوب العدوانية اللفظية لدى مؤيدي السلطة الجديدة في مواجهة أي نقد لمسالكها حتى فيما اعترفت بها هي نفسها وشكلت «لجنة تقصي حقائق» بشأنها. مجمل القول هو أن الرصيد الكبير (المشروط) الذي حصلت عليه السلطة الجديدة في الداخل والخارج آخذ في التآكل كل يوم مع تراجع الآمال التي عقدت على التحول الكبير الذي تمت المراهنة عليه.
لن أدخل في تفاصيل نقد الإعلان الدستوري الذي قام به كثر وشمل مختلف مفرداته، ولكن من الطريف الإشارة إلى بند يتعلق برئاسة الجمهورية حيث ورد فيه شرط يتعلق بدين رئيس الجمهورية من غير أي إشارة إلى جنسيته، ربما لأن اللجنة الدستورية التي عينها الشرع لم تخطر ببالها هذه الثغرة الخطيرة حتى لو تعلقت باحتمال قريب من الصفر. فوفقاً لهذا الشرط يمكن لأي مسلم أن يشغل منصب رئاسة الجمهورية حتى لو كان غير سوري الجنسية، مع العلم أن هيئة تحرير الشام وفصائل جهادية أخرى فيها أعضاء أجانب من جنسيات مختلفة، وبينهم من تم تجنيسهم على عجل وبصورة غير معلنة!
لعل غموض أجندة الفريق الحاكم، وبخاصة قائده أحمد الشرع، في مسائل أساسية كشكل الدولة ونظام الحكم وغيرها، هو ما شجع كثيرين على المراهنة على تغيير لا بد أن يطال برنامجهما الأيديولوجي المعروف القائم على الفكر السلفي والنزعة الطائفية السنية. لكن هذا الغموض لم ينجلِ في الفترة المنصرمة إلا عن أسوأ الكوابيس التي استبعدها السوريون، فتفجر العنف الطائفي واتضحت الميول السلطوية والإقصائية من غير أن يظهر ضوء في نهاية النفق حتى لو كان طويلاً بحكم حجم المشكلات الهائل وضعف وسائل معالجتها.
وعلى رغم هذه المؤشرات المقلقة، يبقى أن السلطة ما زالت ضعيفة وهشة (وهذا بدوره مقلق) وخاضعة لاشتراطات كثيرة أغلبها للأسف خارجي، ستكون مرغمة على التعاطي الإيجابي معها لاستكمال شرعيتها المنقوصة، ولحل مشكلة العقوبات المفروضة على سوريا التي لا تسمح بإطلاق عجلة الاقتصاد، ولا يمكن للسلطة أن تحافظ على ما تبقى لها من شعبية قبل ذلك.
تطفو على السطح، في الحراك الاجتماعي السوري، مشكلة «المكوّنات» التي فشلت السلطة في إدماجها لأنها لم تر في السوريين إلا مكوّنات طائفية وعرقية وثقافية وسعت إلى التحايل عليها بدلاً من معالجتها بروح وطنية. بدا الاتفاق الذي وقعته السلطة مع قسد وكأنه «تاريخي» في أعقاب مأساة أهل الساحل، لكن الإعلان الدستوري بالصورة التي صدر بها قد أضعف من تاريخيته المحتملة، فلا رضيت عنه قسد ولا تيار وازن من دروز السويداء بقيادة الشيخ حكمت الهجري.
لا يمكن للمغمغة بشأن ديمقراطية الدولة وعلمانيتها، وهما شرطان لازمان لقيام دولة في سوريا تمثل جميع مواطنيها، أن تؤسس لهذه الدولة المأمولة، حتى لو تجنب أركان السلطة الكلمتين بذاتهما بحكم الإيديولوجيا التي تحكم تفكيرهم. ما لم تمض السلطة في هذا الاتجاه، ولو بخطوات بطيئة، نخشى سيناريوهات كارثية كتقسيم البلاد أو الحكم بالعنف المعمم مع شعبوية قاتلة. ويحتاج الفريق الحاكم إلى تحالف عريض مع فئات اجتماعية واسعة ليتمكن من تأسيس شرعيته. في حين أن الاستفراد بالسلطة والعجز عن تفكيك الجماعات المسلحة وتوحيد مناطق البلاد هو السائد إلى الآن. سوريا ليست بخير.
كاتب سوري
القدس العربي
——————————-
“تداول آراء” في أولى جولات التفاوض بين دمشق و”قسد”/ محمد أمين
21 مارس 2025
بدأت جولات تفاوض بين الحكومة السورية من جهة، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من جهة ثانية، من أجل تنفيذ مضامين اتفاق وُقّع أخيراً بين الطرفين في دمشق، بهدف دمج هذه القوات في المنظومة العسكرية للبلاد، واستعادة الدولة السيطرة على الشمال الشرقي من سورية. فقد عُقدت أولى جولات التفاوض، أمس الأول الأربعاء، بحضور قائد “قسد” مظلوم عبدي، ومسؤولين أميركيين، في القاعدة العسكرية بمدينة الشدادي بريف الحسكة. وبحسب مصادر مطلعة، عقدت ثلاث جلسات خلال الجولة الأولى من مفاوضات دمشق و”قسد” منها جلسة بين الوفد الحكومي وفريق أميركي، من دون مشاركة ممثلين عن “قسد”. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الفريق الأميركي ذكر لوفد الحكومة السورية أنهم متعاونون (الجانب الأميركي) بأعلى المستويات لإحلال السلام على الأراضي السورية، وطالب الوفد “قسد” بتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بالتفاوض، حسين السلامة، في تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، مساء أمس الأول، أن “النقاش جرى من منطلق المسؤولية الوطنية، وبإرادة مشتركة تهدف إلى وحدة الأراضي السورية وتشمل جميع المكونات من دون إقصاء أحد”. وأضاف: “اتفقنا خلال الاجتماع الأولى على تشكيل لجان عمل متناظرة تخصصية، ستبدأ عملها بداية شهر إبريل/نيسان المقبل”، موضحاً أن عملها سينحصر على “تقريب وجهات النظر وإعداد خريطة طريق لتوحيد الأراضي السورية”.
في السياق، ذكرت “قسد” في بيان، أمس الأول، أنه “جرى تداول للآراء خلال الاجتماع”، مشيرة إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع للإعلان الدستوري (وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع يوم 13 مارس/ آذار الحالي) والحاجة لعدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سورية وكتابة دستور”. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقّع في دمشق يوم 10 مارس/ آذار الحالي، اتفاقاً مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، نصّ على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وعلى وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية. كما أكد الاتفاق أن “المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور”. ونص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سورية التابعة لـ”قسد”، ضمن إدارة الدولة السورية.
الرفض الكردي للإعلان الدستوري يخيّم على اتفاق “قسد” ودمشق
نزع هذا الاتفاق مع “قسد” فتيل توتر على الساحة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقطع الطريق أمام صدام عسكري كان يخشى منه السوريون لحسم مصير الشمال الشرقي من سورية، الغني بالثروتين الزراعية والنفطية. تعاطت الإدارة الجديدة في سورية مع ملف الشمال الشرقي بالكثير من “الهدوء” لتجنيب البلاد دورة عنف جديدة يمكن أن تجر البلاد إلى صدام واسع النطاق على أساس عرقي. واتفق الطرفان، أي الرئاسة السورية وقوات قسد، على الخطوط العريضة، والمبادئ العامة للاتفاق، إلا أن هناك الكثير من التفاصيل التي ربما ستتطلب جولات كثيرة من التفاوض لحسمها، خصوصاً لجهة الوضع النهائي لقوات قسد التي تطالب بدخول الجيش السوري كتلةً واحدة وبقائها الجهة المسيطرة على الشمال الشرقي من سورية.
ملف المقاتلين الأجانب
في المقابل، تصر الإدارة السورية على دخول إفرادي لعناصر هذه القوات التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب” الكردية، والتي يُنظر إليها على أنها الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني، والذي ما تزال كوادره تتحكم بالكثير من مفاصل القرار في شمال شرقي سورية. وربما سيكون ملف المقاتلين الأجانب في صفوف “قسد” والمنتمين إلى “العمال الكردستاني”، معضلة أمام إنجاز اتفاق نهائي بين دمشق و”قسد”. فقد أكد قياديون في تلك القوات، بمن فيهم مظلوم عبدي، أن هؤلاء المقاتلين سيغادرون سورية في حال إتمام الاتفاق مع دمشق. ولا معلومات وإحصائيات يمكن الركون إليها عن عدد المسلحين الأجانب في صفوف “قسد”، إلا أن تقارير إعلامية تتحدث عن ثلاثة آلاف عنصر من أكراد العراق وتركيا وإيران، دخلوا سورية على مراحل. وتصر الإدارة السورية على خروج هؤلاء المسلحين من الأراضي السورية لتفادي تهديدات تركية بالتدخل العسكري في الشمال السوري لإجبار “قسد” على تسليم السلاح.
وقد زوّد التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة “قسد” بأسلحة نوعية خلال الحرب التي خاضتها هذه القوات ضد تنظيم داعش منذ تأسيسها في عام 2015، وصولاً إلى مطلع عام 2019، حين أُعلن عن هزيمة التنظيم في منطقة شرقي نهر الفرات. ومن المرجّح أن يكون مصير هذا السلاح، خصوصاً الثقيل منه من المسائل التي ستطيل عمر المفاوضات، لا سيما أن “قسد” تريد الاحتفاظ بسلاحها. وكان الاتفاق الذي أبرم بين الرئاسة السورية و”قسد” قد نصّ أيضاً على “دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها”، لذا من المتوقع أن تُسند إلى “قسد” مهام من وزارة الدفاع السورية خارج الشمال الشرقي من سورية، في حال التوصل لآليات تنفيذ الاتفاق. ورغم أن الاتفاق بين دمشق و”قسد” ذو طابع عسكري، إلا أنه من المتوقع أن تحاول هذه القوات ربط تنفيذ الاتفاق بالحصول على مكاسب سياسية للأكراد السوريين، في الدستور الدائم الذي من المفترض إنجازه في منتصف المرحلة الانتقالية والمقدرة بنحو خمس سنوات.
عراقيل أمام اتفاق دمشق و”قسد”
رأى المحلل السياسي المقرب من الإدارة الذاتية (شمال شرقي سورية)، إبراهيم مسلم، في حديث مع “العربي الجديد”، أن هناك عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق الذي وُقّع بين الشرع وعبدي “منها القصف المتكرر من قبل الجانب التركي على الشمال السوري وعدم اتخاذ الإدارة الجديدة موقفاً رافضاً لهذا القصف الذي يفضي إلى مقتل مدنيين”. وبرأيه “هناك خطاب كراهية تجاه الأكراد في سورية، أعتقد أنه سيكون إحدى العراقيل أمام الاتفاق”، مضيفاً أن “قسد قدمت تنازلات من أجل الاتفاق، ولكن تنفيذه يحتاج إلى وقت، فالأمر مرتبط بالظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالملف السوري”.
عناصر من “قسد” بدير الزور،4 سبتمبر 2023(دليل سليمان/فرانس برس)
وفي السياق، رأى المحلل السياسي بسام السليمان، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “أصعب القضايا كما يبدو لي هي دمج قوات قسد في الجيش السوري الجديد”. وباعتقاده فإن “ملف الإدارة الذاتية التي شكلتها قسد سيكون من القضايا الصعبة، خصوصاً أن لدى هذه الإدارة نحو 150 ألف موظف يجب دمجهم في مؤسسات الدولة”. كما اعتبر أن ملف “داعش” ومواجهته، فضلاً عن إدارة السجون التي تضم أسرى التنظيم سيكون حاضراً بقوة على طاولة التفاوض بين دمشق و”قسد”. وبرأيه فإن “الحضور الأميركي في هذا الملف سيظل موجوداً ريثما ينتهي ملف التنظيم بشكل كامل، سواء أنجز اتفاق بين دمشق وقسد أو لم ينجز”. وتوقع السليمان أن يكون مسار التفاوض طويلاً بين الطرفين، موضحاً أن “اتفاق دمشق كان اتفاقاً على المبادئ”، والأمر “يحتاج إلى الكثير من الحوار وخطوات بناء الثقة المتبادلة”.
العربي الجديد
——————————
مخاوف كردية بعد الإعلان الدستوري ومجازر الساحل السوري/ شفان ابراهيم
20.03.2025
مجازر الساحل التي تعتبر الانتكاسة الأكبر للوضع السوري الحالي، تركت مختلف المكوّنات السورية، خصوصاً الكردية المتمركزة في الشمال، في حال من القلق من احتمالات حدوث مواجهات مماثلة.
أعادت مجازر الساحل السوري الأخيرة التي استمرّت أياماً، وأدّت إلى مقتل المئات وفرار الآلاف من العلويين، إحياء هواجس تتعلّق بالهوية والانتماء.
تقول شيرين عبد الله، وهي طالبة طب في جامعة اللاذقية، وناجية من المجازر: “لا يُمكن أن تكون المشاهد المروعة طبيعية”، وتضيف: “صوت الرصاص لا يزال يطنّ في أذنيّ، وأصوات الأمهات النائحات، وما زلت أرى الجثث المتناثرة والدماء في كل مكان، لن أنسى هذا أبداً”.
تتحدّث شيرين عن أعمال قتل بخلفية طائفية، حصلت في مناطق الساحل التي يتمركز فيها العلويون، ارتكبتها مجموعات متشدّدة محسوبة على القيادة الجديدة في دمشق، رداً على كمين نفّذه مسلّحون محسوبون على نظام الأسد المخلوع، قتلوا فيه نحو مئتي مقاتل من قوات الأمن السوري، ما أشعل حملة انتقام شعواء تحوّلت إلى مجزرة.
يقول الناشط أمين أمين متحدّثاً عبر الهاتف من اللاذقية: “قتلوهم على الهويّة، فقط لأنهم علويون، القصاص العادل لفلول النظام أمر مهمّ وعادل، لكنه تحوّل إلى شمّاعة، لا يجوز تحميل العلويين جريرة أعمال النظام البائد”.
انتهاء العملية العسكرية لا يعني انتهاء الخوف
لا تزال مناطق الساحل السوري وسوريا عموماً، تعيش تحت وطأة المجزرة، التي يُقدّر عدد ضحاياها بنحو ألف، ورغم مرور أكثر من عشرة أيام عليها، وإعلان القيادة السورية استتباب الأمن في الساحل، وتشكيل لجنة تحقيق، لا تزال المنطقة في حالة صدمة، في حين تفرض السلطات تشديدات أمنية على قاصدي مناطق الساحل، مما أدّى إلى غياب التغطية الإعلامية، إلا من الإعلام المحسوب على القيادة السورية.
مجازر الساحل التي تعتبر الانتكاسة الأكبر للوضع السوري الحالي، تركت مختلف المكوّنات السورية، خصوصاً الكردية المتمركزة في الشمال، في حال من القلق من احتمالات حدوث مواجهات مماثلة.
كان لافتاً توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوّات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، بعدها مباشرة، في خطوة اعتُبرت مهمّة في سبيل توحيد البلاد، لكن هذا لم يمنع عدداً من التنظيمات الكردية من الإعراب عن مخاوفها، من احتمال تمدّد العنف تحت ذريعة مواجهة فلول الأسد.
من ناحيته، حمّل “المجلس الكردي” في سوريا النظام السابق مسؤولية ما يجري، داعياً إلى “تحقيق العدالة والمساواة وحماية المدنيين والأمن العام”.
فلطالما جرّد النظام السوري السابق الكرد من حقّ المواطنة لأسباب سياسية واقتصادية، والإحصاء الاستثنائي الذي أجراه نظام حافظ الأسد في محافظة الحسكة شمال البلاد، شاهد على ذلك، وهناك مخاوف من تطبيق سياسات مشابهة في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة.
إضافة إلى ذلك، فقد شكّل الإعلان الدستوري، خيبة أمل لعدد من القوى الكردية الأخرى، حيث اعتبرته استمراراً لسياسة الإقصاء والتهميش، التي اتّبعها نظام البعث المخلوع ضد الكرد.
إعلان دستوري لا يحترم حق المواطنة
أثار مضمون الإعلان الدستوري الكثير من الهواجس والانتقادات من قبل مكوّنات سورية، خاصة لجهة تحديد دين رئيس الجمهورية، وحصر هويّة الدولة السورية بالعربية، والاقتصار على اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة في البلاد.
المدير التنفيذي لـ “المرصد الآشوري لحقوق الإنسان” جميل دياربكرلي، اعتبر في تصريح لـ”درج” أن الإعلان الدستوري “يمثّل انتهاكاً صارخاً لأحد أقدس المبادئ الإنسانية، ألا وهو مبدأ المواطنة المتساوية. هذا الإعلان لا يُقسّم السوريين إلى درجات فحسب، بل ينسف أسس الدولة المدنية الحديثة، التي يجب أن تقوم على المساواة التامّة بين جميع مواطنيها”، ورأى أن “حرمان غير المسلمين من حقّ الترشّح لرئاسة الجمهورية هو تمييز سافر، ينفي عنهم صفة المواطنة الكاملة، ويجعلهم رعايا من الدرجة الثانية، لا بل العاشرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المكوّنات القومية غير العربية، التي يُنتقص من حقوقها ويُحصر وجودها في إطار ثقافي ضيّق، وكأن أبناءها ليسوا جزءاً أصيلاً من النسيج السوري”.
يصف دياربكرلي الإعلان الدستوري أيضاً بأنه “وثيقة قانونية، بل صكّ تفرقة عنصرية، يُعيد سوريا إلى عصور الظلام، حيث تسود قوانين التمييز والإقصاء، والأخطر من ذلك، أنه يكشف عن نزعة استئثارية لدى القيادة الجديدة، تسعى إلى احتكار السلطة، وتطبيق نموذجها المتطرّف في عموم سوريا، تماماً كما فعلت جبهة النصرة في مناطق سيطرتها”.
الرأي القانوني لكرد سوريا
بحسب حقوقيين وقانونيين كرد، فإن الإعلان الدستوري يُسيء لمفهوم الدولة الوطنية والمواطنة الكاملة، كونه “لم يعترف بالكرد كثاني قومية في البلاد، ولم يتمّ ذكر أن سوريا بلد متعدّد القوميات والأديان… كما أنه حصر كامل السلطة بيد رئيس الدولة، ومنحه صلاحيات تُشبه إلى حد بعيد صلاحيات الحاكم العرفي، إضافة إلى أنه أسقط مبدأ فصل السلطات، الذي يُعتبَر ضمانة لحُسن سير العملية السياسية، علاوة على أن التوجّه العروبي البعثي واضح في اسم الدولة، ويُوحي بوجود حكم شديد المركزية، ولا يعترف دستورياً بأي مكوّن آخر…”.
عضو الأمانة العامة لـ “المجلس الكردي” أكرم حسين، أبدى تخوّفه على مصير البلاد ومستقبلها، معتبراً أن “الإعلان الدستوري يتجاهل التعدّدية القومية بشكل واضح، حيث يصف سوريا بأنها جمهورية عربية، من دون الاعتراف بالكرد أو القوميات الأخرى”، وأشار إلى أن “تعيين أعضاء مجلس الشعب من قِبل الرئيس، بدل انتخابهم في المؤتمر الوطني السوري الذي كان ينبغي عقده، يُفقد المجلس شرعيته الشعبية، ويُكرّس المركزية، مما يُعيد إنتاج النظام القديم”، كما انتقد حسين النصوص المتعلّقة بالحقوق والحريات، واصفاً إيّاها بأنها “جاءت فضفاضة وغير محدّدة بآليات تطبيق واضحة، مما يترك مجالاً لتقييدها مستقبلاً، في حين أن تضمين العدالة الانتقالية في الإعلان، هو خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى آليات ملموسة لضمان المحاسبة وإنصاف الضحايا”.
يُثني حسين على الجوانب الإيجابية التي أتت في الإعلان الدستوري مثل “استقلال القضاء وحلّ محاكم الإرهاب”، لكنه يرى أن الإعلان بشكله الحالي “لم يقدّم حلاً شاملاً للأزمة السورية، ولم يقدّم ضمانات حقيقية للشراكة الوطنية للمكوّنات غير العربية، بخاصة الكرد، حيث حصر دين رئيس الدولة بالإسلام، وجعل الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع، مما يُخلّ بمبدأ المواطنة المتساوية، ويؤدّي إلى إقصاء الأقليات الدينية الأخرى وتهميشها، لأن الدولة يجب أن تكون حيادية تجاه الأديان، وهناك تركيز للسلطة التنفيذية بيد الرئيس، من دون أي ذكر للا مركزية السياسية أو الإدارية”.
الموقف الرسمي من الإعلان الدستوري
وتتشابه مواقف “المنظّمة الثورية الديمقراطية” و”المجلس الوطني الكردي” من الإعلان الدستوري، حيث أكدت أربعة مصادر من الطرفين، رفض الإعلان الدستوري بصيغته النهائية على اعتباره “لا يُلبّي تطلّعات الشعب السوري في بناء دولة المواطنة والديمقراطية، بل يعكس استمراراً لنهج الإقصاء والتهميش بحقّ المكوّنات القومية والدينية السورية، ويكرّس مبدأ عدم المساواة بين المواطنين”، كما سجّلت اعتراضها على “اسم الدولة وتجاهُل التعدّدية القومية، واشتراط الإسلام ديناً لرئيس الجمهورية، واعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، وتجاهُل المكوّنات القومية والدينية غير العربية وغير المسلمة، وإغفال الدور السياسي للمرأة، ومنح صلاحيات واسعة جداً لرئيس الجمهورية”.
درج
———————————
“قسد” ودمشق .. مصالحة شاملة أم اتفاقات مؤقتة؟
الحرة – واشنطن
21 مارس 2025
تباينت ردود فعل السوريين حول أهمية الاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ووفد من دمشق حول ضرورة وقف النار وتأثير ذلك على الوضع في البلاد.
فبينما يرى البعض أن هذا الاتفاق خطوة هامة نحو توحيد الصفوف وتعزيز الموقف السوري في مواجهة التحديات الإقليمية، يعتبر آخرون أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الدعم التركي لفصائل مسلحة من جهة، ومن جهة أخرى، وعدم مشاركة مكونات أخرى في العملية السياسية.
ومع تعهدات بوقف الصراع، تبقى الأسئلة حول مدى جدية التنفيذ والتزام جميع الأطراف مطروحة.
وحدة الصف .. تعزيز لموقف دمشق
فراس الخالدي، منسق منصة القاهرة وأمين عام شباب الحراك الثوري، من دمشق، قال في حديثه لقناة “الحرة” إن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، كان حريصًا منذ البداية على التأكيد على أهمية الحفاظ على سوريا “كيانًا واحدًا لا يتجزأ، أرضًا وشعبًا”.
وأوضح الخالدي أن الأزمة في شمال شرق سوريا جاءت نتيجة تعاطي الأكراد مع نظام قمعي على مدار 50 عامًا، حاول من خلاله تهميشهم وانتهاك حقوقهم.
وأضاف أن السلطات السورية الجديدة تتبنى منطقًا مختلفًا، يعتمد على المساواة، وأن سوريا هي لجميع أبنائها دون تمييز بين مكونات الشعب.
وأشار الخالدي إلى أن توحيد الصفوف بين قسد ودمشق سيعزز موقف الحكومة السورية الجديدة، ويجعلها أكثر قدرة على الضغط على أنقرة لوقف الهجمات التي تستهدف المناطق في شمال شرق سوريا.
وبيّن أن الإدارة السورية الجديدة جادة في تعهداتها بوقف الصراع ومنع أي جهة، “مهما كانت”، من الاستمرار في الاقتتال.
كما ذكر أن الشرع كرر مرارًا أن “الدم السوري حرام”، وأن حل المشاكل السورية مرتبط بوحدة الصف ودعم المكونات المختلفة للحكومة الجديدة.
وأضاف الخالدي أن عدم مشاركة جميع الأطراف السورية في العملية السياسية لا يعني إقصاءً لها، بل إن المرحلة الحالية تتطلب آلية مختلفة للتعامل مع العقلية السياسية، موضحًا أن “نحن في مرحلة بناء دولة، حكم، توفير الأمن، وتعزيز الاقتصاد، ومن ثم تأتي مرحلة الحقوق وتشريع القوانين”.
وأكد أن التحديات الحالية أهم من المطالب المتعلقة بالمحاصصة والمشاركة في العملية السياسية.
الاقصاء .. مشكلة تعقد الأزمة
فوزة يوسف، عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي من القامشلي، قالت بدورها لقناة “الحرة” إن قسد والإدارة السورية الجديدة في دمشق لديهما رؤى موحدة بشأن أهمية وقف القتال ومنع حدوث صدامات عسكرية في عموم سوريا.
وأوضحت أن الاتفاقية الأخيرة قد رسخت هذه الرؤى بشكل أكبر، لكنها أضافت أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في وجود فصائل مسلحة موالية لتركيا، ما زالت تهاجم مناطق في شمال شرق سوريا، مثل سد تشرين.
وأعربت يوسف عن أسفها لاستمرار القتال رغم الجهود المبذولة لوقفه، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يمس سيادة سوريا، ولفتت إلى أن توسع النفوذ التركي بعد سقوط نظام الأسد سيكون له تأثير كبير على موقف دمشق.
وأوضحت أنه على الرغم من وعود السلطات السورية الجديدة بالتدخل، وطلبها من الجانب التركي وقف هذه الهجمات، إلا أن الواقع على الأرض لم يتغير، “والأزمة ما زالت مستمرة بدون حل”.
وأضافت يوسف أن وحدة الصف التي تدعو إليها دمشق لا يمكن أن تتحقق من طرف واحد، بدليل عدم مشاركة المكونات السورية الأخرى في الحكومة الانتقالية واللجنة الدستورية.
وأكدت أن سياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها دمشق ستجعل موقف هذه الحكومة ضعيفًا.
وفي الختام، أوضحت يوسف أن توقيع الاتفاقية الأخيرة لا يعني “نهاية المشاكل، بل هو بداية حسنة وتأكيد على موقف قسد المبدئي”.
وأعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” الأربعاء أنها اتفقت مع وفد دمشق على ضرورة وقف النار في كامل سوريا، وذلك خلال لقاء جمع القائد العام لقواتها مظلوم عبدي ولجنة من الإدارة السورية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل اللجان والتي من المقرر أن تبدأ العمل بشكل مشترك مع بداية شهر إبريل.
كما تطرق الاجتماع للإعلان الدستوري والحاجة لعدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سوريا وكتابة دستور، وتوقف الاجتماع مطولاً على ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.
القائد العام لقواتنا يستقبل لجنة من الإدارة السورية
اجتمع القائد العام لقواتنا “مظلوم عبدي”، اليوم، الأربعاء، مع اللجنة التي شكّلها الرئيس السوري “أحمد الشرع” لاستكمال الاتفاق بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
شارك في الاجتماع عضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة…
— Syrian Democratic Forces (@SDF_Syria) March 19, 2025
تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الرئاسة السورية أن “قسد” التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد وقعت اتفاقا للانضمام مع مؤسسات الدولة الجديدة.
ويقضي الاتفاق بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها قسد بمشال شرق البلاد مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز تحت سيطرة دمشق.
وعبر سوريون بعد هذا الاتفاق عن أملهم بتحسن الواقع الخدمي والمعيشي المتردي في البلاد بعد 14 عاما من حرب طاحنة.
الحرة – واشنطن
————————————–
مقاومة النقص: عن الصدع بين قامشلي وقامشلو/ دارا عبدالله
21-03-2025
في شتاء عام 1995، دخل والدي، نواف عبدالله، والسياسي الكردي الراحل إسماعيل عمر إلى بيتنا مُحمّلين بمجموعة من صناديق الكرتون. في غرفة الضيوف، رُكِّب الكمبيوتر الذي يجب أن يبقى خبر وجوده في البيت سراً. مع الكمبيوتر، توجد طابعة ليزريّة، تُغطَّى بقطعة قماش، والطابعة سرّ أخطر من سر الكمبيوتر، وهي آخرُ ما يُفشَى. حتّى عام 2005، كان بيتنا في القامشلي، حوشاً عربياً كبيراً فيه شجرة برتقال ثمارها تصلح للعصير فقط، ودالية ضخمة، وينتهي هذا الحوش بـ4 غرف طينية. إثر الحتّ والتآكل والذوبان المستمر الذي تسببه الأمطار، تحتاج البيوت الطينية إلى طيانة سنوية، لأنّ ترقُّق السقف يزيد احتمالات الرشح من الأعلى. لم يكن نادراً أن ترى في إحدى غرف البيت طاسة مياه تستوعب القطرات الهاطلة من موضعٍ هَزُل فيه السقف، والمسافة الزمنية بين القطرات تكون أحياناً 30 ثانية، وتضيق اضطراداً مع تعمّق النخر. يوم الطيانة جنّة كل طفل، إذ تختفي القوانين وتغيب معايير النظافة، ويزول الفرق بين الداخل والخارج، ونتلذذ بلدغات القشّ على القدمين عند الدعس على الطين. في يوم الطيانة، كان من الضروري التفكير بالكمبيوتر، وذلك بأنّ يكون السقف فوقه في غرفة الضيوف مدعوماً بالطين أكثر كي تقلّ احتمالات الرشح.
مع دخول الكمبيوتر، توضَّح أكثر الدور القيادي لوالدي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) في سوريا، وصار الوجود الصميمي، والذي لا توجد له أيّ بداية في ذاكرتي، لإسماعيل عمر، أبو شيار، في بيتنا مفهوماً. لحزب الوحدة منشورات سياسيّة وثقافيّة باللغتَيْن الكرديّة والعربيّة؛ باللغة العربية نشرة حزبيّة شهريّة اعتياديّة (فيها افتتاحية يكتبها أبو شيار، وأحياناً والدي) ومجلّة «الحوار» الثقافية الفصلية، وهي المعادل الموضوعي لموقع «الجمهورية» في الصحافة الكردية في التسعينيات وحتى منتصف الألفية، إذ كانت المجلّة تنشر أبحاثاً معمقة ومقالات طويلة. وباللغة الكردية، يُصدر حزب الوحدة مجلتي Newroz وPires (وتعني سؤال بالكردي). الطابعة لا تطبع هذا فقط، بل كل البيانات العاجلة والمنشورات الاستثنائيّة والمواقف المشتركة مع الأحزاب الأخرى، سواء الأحزاب الكردية أو أحزاب المعارضة السورية العربية.
لمدة، كانت تستمرُّ أحياناً ليلتَيْن، كان بيتا يتحوّل إلى ورشة عمل صحفية: أبو شيار يكتب بيده ويختار ويصحح ويدقق، وأبي ينسّق على «الوورد» ويناقش ويدقق ويمازح. في النهاية، كانت تتشكّل كومة زائدة من الأوراق لنصوص عُدّلت أو لنسخٍ مكررة. تُرسَل النسخ النظيفة إلى المطبعة السرية، ولكن الكمبيوتر في غرفة الضيوف كان دوماً مصدر النسخة الأولى، وتوضَع واحدة احتياط على القرص المرن (موقعه التطوّري يشبه قِدَم موقع «المنجل» في عالم التكنولوجيا الزراعية). في الليل، كان والدي يجمع الأوراق في الحَوْش، لأنّ اكتشافها في أي مداهمة يعني غياباً عنّا لسنوات، والحريق في الحوش يشير إلى أنّ نهاية الشهر قد حلّت، ورؤية الرماد، تعني أنّ النسخ الأولى قد خرجت.
على إيقاع عبارة سيمون دي بوفوار: «لا تولد كردياً… بل تصبح كردياً». يزولُ الضباب من إشكالية أنّك كرديّ بالتوازي مع نموّك السياسي: الصراع داخل الكلمة بين قامشلي وقامشلو، والأمكنة التي فُصِلَت عن أسمائها، إذْ تمّ تحوير اسم بلدة «تربي سبي» لتصبح «القحطانية»، وعين العرب عمياء، لأنّ نسبة العرب لم تتجاوز 10 بالمئة داخلها، وهي في عين 90 بالمئة من سكانها كوباني؛ الُمقاطعون اجتماعياً مَنْ لا يدعسُ أحد عتبة بابهم، وأعراسهم صغيرة وخيم عزائهم فارغة، لأنّهم بعثيون؛ القتلى الدائمون في عيد النيروز، واللغة الكردية التي يجب تُوشْوَش في المؤسسات، إذْ ربما يُقال لك أن تصمت، وألا تُشغّل هذا «اللسان الأعوج» مجدّداً. تصبح كردياً لمّا تفهم أنّ أولاد عمتك لا يكملون التعليم العالي لأنهم مكتومو القيد، ممن شملهم الإحصاء الإبادي الذي جرى عام 1962، واستهدف بشكل مخصوص الأكراد السوريين. رغم أنّ عمتك كانت «مواطنة»، إلا أنّ زواجها من كردي طارئِ مكتومٍ ثبَّط «مواطنتها»، ونقلت عبر مشيمتها «كتم» زوجها إلى أولادها. أحدهما، إمّا الأب أو الأم، كافٍ لنقل صفتَي «الكتم» أو «الأجنبية» إلى الذريّة.
قسَّمَ قانون إحصاء الحسكة الأكراد السوريين إلى ثلاث فئاتٍ تتمتّع بثلاث درجات متفاوتة من الحقوق. تم اختيار عام 1945 كمعيار. وفي عام 1962، مَن استطاع إثباتَ إقامته في البلاد قبل عام 1945 حصل على الجنسية السورية، ومن ذهب إلى الدوائر البيروقراطية للدولة البعثية وسجّل نفسه في القوائم ونجح في إثبات «سوريته»، ولكنه فشل في إثبات عمقه الزمني قبل عام 1945، صار «أجنبياً»، ومن لم يُدرَج في أي قائمة أو فشل في إثبات «سوريته»، صار «مكتوم القيد». هنا نقطة توقُّف على حقيقة تاريخيّة: حصلت سلسلةٌ من الهجرات الكردية من تركيا إلى سوريا بعد ثلاثة أحداث سياسية وانتفاضات شعبية في المناطق الكردية داخل تركيا. لدينا ثلاث هجرات أساسية: هجرات ثورة الشيخ سعيد بين عامي 1925 و1927، وهجرات ثورة آرارات عام 1930، وهجرات انتفاضة ديرسم بين عامي 1937 و1938. أزعمُ بأنّه، حتّى الآن، لا توجد أرقام دقيقة للهجرات الثلاث مجتمعة، ولكن الأعداد تُقدَّر بعشرات الآلاف. أخوالُ والدي، أكراد يقيمون في تركيا. الهجرات لم تكن إلى القامشلي وعفرين وكوباني فقط، بل كانت حقنة في كلّ الجسد السوري، وأدت إلى تطوير أنماط مختلفة من الهوية الكرديّة. من استقروا في دمشق، طوّروا هوية كردية صارَت أصلاً اجتماعياً وفترة في النسب، غير مُحفّزة سياسياً ومُنحّاة لصالح هوية شامية محافظة، ومن استقروا في الجزيرة تديّنوا بشكل أقلّ، وتوزّعوا بين الأحزاب الشيوعية والأحزاب القومية.
مكتومو القيد، الجريمة طويلة الأمد، هم الوجه الإبادي الدائم للبعثية الإقصائية، إذْ يُعبَّر عنهم رسمياً بورقة من مختار الحي فقط. يولد مكتومو القيد ميّتين، وهم جماعة وجدوا فقط كي يذكَّروا بشكل دائم بأنهم غير موجودين. مجموعة قُتِلَ تمثيلها مع إبقائها معتقلة وحبيسة وضعية الصامت، إذْ أنّها ممنوعة من إصدار أي جواز سفر، ومطمورة في مكانها للأبد. تبتلعُ التربة موتاها دون أوراق ثبوتية، ويُذكَر أفرادها فقط في قصص أبنائهم. الفرق بين الأجانب ومكتومي القيد هو فرقٌ بالحقوق الناقصة. غير مُعتَرِفٌ بالمكتوم مطلقاً، في حين ثمّة التفاتةٌ بطرف العين إلى الأجنبي. المكتومون مُجمّدون مكانياً، لا يحقّ لهم التحرّك، وممنوعون من التعليم والعمل في القطاعين العام والخاص. الأجانب مُبعدون فقط من القطاع العام، ويحقّ لهم التعليم المشروط والحركة داخل القطر العربي السوري، ولكنهم، مثل مكتومي القيد، ممنوعون من جواز السفر وتسجيل الملكية. مكتومو القيد ممنوعون حتّى من تسجيل أطفالهم، ليتضخّم الورم السرطاني متفشياً في كل الجسد السوري.
من أحد ملامح قسوة سوريا أنّ كلمة «البويجية»، المهنة التي كانت مصيراً لمكتومين كُثر، صارت نعتاً قومياً عنصرياً. عدد الأجانب والمكتومين قُدِّر بـ600 ألف إنسان عام 2011. تقسيم الأكراد السوريين إلى ثلاث فئات متفاوتة في نقصها، خلَق ما يمكن أن يسمّى بـ«وعي مشوه للنقص» في الشخصيّة السياسيّة الكرديّة السوريّة؛ لمّا يتمعّن الأجنبي في وضع المكتوم يرى الجانب الملآن من الكاسة ويعضّ على جرحه، ولما يرى المُجنَّس وضع الاثنين يتحوّل نقصه إلى كمال. المجنّس يتفرّج كيف أنّ المكتوم غريق، وكيف يتمّ إيهام الأجنبي بالغرق. السياسة الكردية السوريّة هي مقاومة هذا الوعي المشوّه بالنقص، عبر تحويل قضية الأجانب ومكتومي القيد الأكراد في سوريا إلى قضية نضالية، سورية وطنية وقومية كردية، عاجلة وملحة. السياسة في سوريا، يجب أن تكون مُقاوِمَة لعملية خلق الوعي المشوّه بالنقص التي يحاول النظام فرضها على الصعيد الوطني، وذلك بالسعي إلى سوريا لا أحد ناقص فيها.
مسار أن تصبح كردياً ليس مسار تعلُّم ما يجب أن تقوله، بل مسار امتلاك مهارة الادعاء الدائم، وتعلّم ما لا يجب أن تقوله. هنا ثمّة فرق؛ ما يجب أن تقوله هو الهراء الممنهج والإنكار الذاتي، في حين ما لا يجب أن تقوله، هو بالضبط ما يشكّلك. درجة الصمت المطلوبة من الكردي السوري أعمق وأشمل وأكثر جذريّة، إذْ أنَّ السوريّ غير الكرديّ ينكرُ نفسه أمام النظام فقط، في حين أنّ الكردي السوري ينكر نفسه أمام الجميع. الكردي السوري هو مكتوم الروح، الشبح الصامت خلف النافذة البعثية المفيّمة، حيث لا يكتملُ إلا في صمته.
الحدث السياسيّ المؤسّس لأبناء جيلي، أي مَنْ هم في منتصف الثلاثينيات الآن، من الأكراد السوريين، هي انتفاضة آذار (مارس) 2004. في 11 آذار، أي قبل يومٍ من المظاهرة الكبرى، كنّا في زيارة عائليّة دوريّة إلى بلدة اليعربية – تل كوجر حيث بيت جدّي من طرف أمي. على الأقل 15 بالمئة من طفولتي كانت في اليعربية، وهي آخر بلدة حدوديّة على الحدود السورية العراقية، وتقابلها في الجهة العراقيّة بلدة ربيعة. على الخط الحدودي توجد شاخصة صورية، على وجهها السوري صورة لحافظ الأسد، وعلى وجهها العراقي صورة لصدام حسين. تبدو صورة حافظ إدراجاً متعمداً ونشازاً سياسياً لأنّ شعبية أبو عديّ أمامه وخلفه. تلقّى والدي اتصالاً بضرورة العودة إلى قامشلو لأنّ الوضع على شفا الانفجار والمدينة تغلي.
لم ندرك طبيعة الأمر، خصوصاً أنّ أحداث الشغب بين جمهوري نادي الفتوة ونادي الجهاد هي أمر اعتيادي. مشجّعو كرة القدم هم الوجه الفاشي للجماعات، إذْ كأنّ ذوبان الفرد واختفاءه في حشد المشجعين يقلل من الرقابة الذاتيّة ويخرُج مكبوت الجماعة المسكوت عنه. الفتوة هو فريق دير الزور، وبالتالي تعبيرٌ عن النرجسية الجريحة بسقوط الصداميّة، والجهاد هو نادي العصب الكردي، وبالتالي تعبير عن التنهيدة الكردية بزوال الصدامية وتحقق البارزانية. عدنا إلى قامشلو التي تبعد 100 كيلومتر عن اليعربية لنجد الناس مجتمعين في المشافي يبحثون عن قتلاهم، والأمّهات يندبن أطفالهنّ والنيران تخرج من بعض السيارات… هنالك قتلى بالعشرات.
في اليوم التالي، خرجت أكبرُ مظاهرة سياسية في تاريخ الأكراد السوريين على الإطلاق. حشود الناس تكدّست من جامع قاسمو حتّى دوّار العنترية، أي من شرق المدينة إلى غربها، ولم يكن المشي ممكناً لأنّ كلّ المسافة التي من المفترض أن يمشيها المتظاهرون امتلأت بالناس فعلاً. فتح النظام النار وقتل في يومين عشرات الشباب، وزجّ بالآلاف في السجون، اختفى الكثيرون منهم تحت التعذيب لاحقاً، و«انتحر» أكثر من 25 مجند كردي سوري في الجيش، وفُصل المئات من وظائفهم، ومشّطت اتحادات الطلبة في الجامعات بحثاً عن الطلاب الأكراد. يوم واحدٌ في تاريخ جماعة غيّر مستقبلها السياسي للأبد، كيف لا وقد أسقطوا ثلاثة تماثيل: حافظ وهو يرفرف بيده، وبشار بالبدلة العسكرية والنظارات الشمسية، وباسل على الحصان.
فيديوهات هدم التماثيل مع العبارات باللغة الكردية المعبرة عن اللعنة الأبدية وشفاء الغليل هي ذروة النشوة السياسية لانتفاضة آذار. لم يحرّك المشهد باقي السوريين سياسياً، لأنّ الأبد أسُقِط باللغة الكردية. الارتياب من اليد الكرديّة في الإسقاط، تغلّب على أي تفكير باحتمال مدّ اليد للمشاركة في الإسقاط. أمّا الخطيئة الأصليّة المُرتكَبة، فهي إظهار فيروس «الحس المتوجه للخارج» و«العين يلي طالعة لبرّا» المغروس في جوهر الأكراد السوريين بحسب خطاب البعث، إذْ رفعَ البعضُ الأعلام الأميركيّة، ليهرَع المسؤولون الحزبيون إلى المطالبة بتنزيلها لأنّ هذا «آخر ما نحتاجه الآن». في الرابعة عشرة من عمري، ناديتُ شخصياً بالاسم المُكرَّد للرئيس الأميركي، جورج بوش الابن، وهو: «بافي أزاد»، وتعني «أبو الحرية» بالكردية.
كان لإسماعيل عمر دوراً محورياً في أحداث آذار. وُلِد أبو شيار في قرية قرى قوي التابعة لبلدة الدرباسيّة عام 1947 ورحل عن عالمنا عام 2010. التحق بجامعة دمشق في شبابه ودرس الجغرافيا وتخرّج عام 1969، وشارك، للمفارقة، في حرب تشرين ضد الاحتلال الإسرائيلي كقائد سرية برتبة ملازم. عمل مدرّساً لمادة الجغرافيا في ثانويات النساء بمدارس القامشلي حتّى استقال منها وتفرّغ تماماً للعمل السياسي الحزبي في نهاية الثمانينيات. طالباته كُنّ يخجلْنَ منه ويختفيْنَ بحضوره حتّى وهنّ في أربعينياتهنّ. لأبو شيار بُعدان: الأوّل سياسي – تنظيمي يسعى لخلق أغلبية كرديّة سوريّة تتجاوز الاستقطاب الأوجلاني – البارزاني التقليدي، وشكّل مع السياسي الكردي المخضرم الراحل عبد الحميد حاج درويش، عرّاب الحزب الديمقراطي التقدّمي الكردي، ما يمكن أن يُسمَّى بالقطب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا.
البعد الثاني لأبو شيار هو حُضوري – اجتماعي. يتواجد في كلّ مكان، وتقبّله حتّى المحجبّات في عيد النيروز، نادر التواجد في الأفراح وأكيد الحضور في الأتراح، ويُسمَع ولا يُقاطَع لأنّه يَسمع الجميع ولا يقاطِع أحداً. آمن أبو شيار بضرورة تجنّب الدولة قدر الإمكان في مسائل تحقيق العدالة. الأكراد غير متساوين أمام القانون، ومطرودون من عملية الصناعة خلف القانون، ويجب أن يكون لديهم القدرة على تجنّب طلب العدالة من دولة غير عادلة جذرياً إزاءهم. الشكوى للدولة هي آخر حل، إذْ كان يحقن الدماء ويوصل الأرحام ويبطل الثأر ويهدّئ النفوس.
لا بداية لوجود أبو شيار في ذاكرتي، إذْ اختبأ في بيتنا بشكل متقطَّع بعد الحملة الأمنية الدموية التي شنّتها مخابرات حافظ الأسد ضد قيادات الحزب عام 1992. نظّم حزب الوحدة حملة ملصقات ومنشورات تُعرِّف بقضية أجانب ومكتومي محافظة الحسكة، تعرَّضت على إثرها قيادات الحزب لملاحقات أمنية، ومَن اعتُقل حوكم لسنوات بعد محاكم شكليّة من أمن الدولة. وضع لرفاقه خطّة بسيطة لتجنّب انهيار الحزب وتقليل الأضرار، وهي الإجابة على سؤال «من أعطاك الملصقات» عند التحقيق بـ«أبو شيار». رجل شاهق بظلّ عال وذهن حاد، أقدم ما أتذكره منه، كيف كان ينوسُ مشياً بين يمين الغرفة ويسارها. الخمول الجسدي نتيجة الاختباء المديد يُكسِلن الذهن، والطريقة الوحيدة لإشعال التفكير هي الحركة المنتظمة العمياء.
على اليمين والدي نوّاف عبدالله، وعلى اليسار السياسي الكردي الراحل إسماعيل عمر أبو شيار/ صورة شخصية من أرشيف العائلة
الفلسفة السياسية لعبد الحميد حاج درويش وإسماعيل عمر واضحة: تشكيل تيار وطني كردي سوري يؤمن أنّ حلّ المسألة الكرديّة في سوريا لا يتمّ سوى بتحوُّل ديمقراطي جذري في كلّ سوريا. نقص الأكراد لا يُعالَج إلا بمعالجة نقصّ كل السوريين، ونقص كل السوريين لا يُعالج سوى بمعالجة نقص الأكراد. المنطلق دمشق، لا أربيل ولا قنديل، وفي اللقاءات الصحافية كان أبو شيار يعترض على حصر الأسئلة بالشأن الكرديّ لأنّه: «حتّى يحكي السوريون بشؤوننا، يجب أن نحكي بشؤونهم أيضًا». لإسماعيل مشروعان توحيديّان، توحيد المعارضة السوريّة، إذْ كان من مؤسسي «إعلان دمشق»؛ وتوحيد الحركة السياسية الكردية بتشكيل مرجعية كردية عليا تسعى لعقد مؤتمر كردي عام. من خلال جلسات «إعلان دمشق» تعرّف على الحقوقية والكاتبة السورية رزان زيتونة، والتي زارت بيتنا في القامشلي كي توثّق حجم الكارثة اجتماعياً وحقوقياً بعد عام 2004.
في انتفاضة آذار، فهم السياسيان الكرديان، إسماعيل عمر وعبد الحميد حاج درويش، خطورة اللحظة. لا مباركة لفكرة «مدينة خارج الدولة»، وكلّ انسحاب كامل مرفوض، لأن ما سيعقبه هو اقتحام كاسح، وكابوسهما كان لجوء النظام إلى اللعبة الأسدية المفضّلة، شارع ضد شارع، وذلك بتسليح قامشلي ضدّ قامشلو. لو سلّح النظام البعثي العشائر العربية وتحوّلت الانتفاضة الكرديّة إلى نزاع عرقي مسلح، ستحترق كلّ طبخة المشروع الكردي الديمقراطي السلمي. السلمية واللاعنف من مبادئه الأولى. كالطيور التي تهلع قبل الزلازل، خرج أبو شيار من بيتنا لحضور اللقاء الأمني الوحيد الذي شارك به مع وفدٍ من دمشق، إذْ دعا إلى شيء واحد فقط: التهدئة والحمائيّة وعدم التصعيد، وذلك في وقتٍ كان التستوستيرون القومي الكرديّ المُفرَز برزانياً في أعلى تراكيزه.
إسقاط الأبد بالكرديّة لم يحرك مشاعر أحد، ولم يقرأ الآخرون المشهد بأنّه تحرّر وطني سوري جماعي، بل فُهِمَ كاقتطاع صهيو-أميركي مدسوس. النظام خبيث، في مواجهة الضغط من غير الأكراد يفعّل العصب الطائفي، وفي ومواجهة الضغط من الأكراد يفعّل العصب القومي. القوّة الأمنية في منطقة الجزيرة السورية هي الأكثر تنوّعاً طائفياً، بسبب الغياب الكامل لأيّ تأثير كرديّ في أي بنية عسكرية – أمنية بسوريا. في الجزيرة السورية ليس بالضرورة أنّ تكون القوة الأمنية مهيكلة بغلبة لون طائفي معيّن، بل يكفي أن تكون عربية. نحن أمام فكّي كماشة: نظام عنفه يتّسم باللامعقول، وقادر على الإبطال الجوهري لفكرة النضال السلمي، وسوريون غير أكراد يروننا خنجراً يجب أن يبقى في الغمد. فَتحُ حرب ضد الأكراد سيقلل التناقض بين النظام والسوريين غير الأكراد، وسيصبح للنظام قضيّة بدلاً أن يكون للأكراد قضيّة.
أحداث آذار كانت صرخةً ارتدت إلى حنجرتها، تشطيباً للجسد كتنفيسٍ عن احتقانٍ للروح. ما حصل كان قفزة إلى الفراغ، وما رآه أبو شيار هو الوقوع بأفضل طريقة ممكنة، وهذه الحمائيّة السياسية شكّلت ملمحاً أساسياً من ملامح السياسية الكردية السوريّة، خصوصاً بعد انطلاقة الثورة السورية عام 2011.
وقعت الثورة السورية، وما حصل هو أنّ النظام عام 2012، سلّم المنطقة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الصدى السياسي والعسكري لحزب العمال الكردستاني PKK، وتأسست على إثرها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة. بعدها، جاءت سلسلة من الأحداث التي أثّرت جذرياً في تطوّر المشهد السياسي والعسكري في منطقة الجزيرة السورية. الصدام الأوّل حصل في محاولات جبهة النصرة اقتحام مدينة رأس العين- سري كانيي في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، و«انهيار الإطار الوطني للصراع السوري»، وارتفاع مستوى التأثير التركي. الحدثان المؤسّسان لقسد هما: مجزرة كوباني لمّا تعرّضت إلى اقتحام من قبل داعش في 13 أيلول (سبتمبر) عام 2014، وإبادة الإيزيديين القروسطيّة في جبل شنكال في 3 آب (أغسطس) 2014.
قسد لم تكن فقط إملاءً أميركياً، بل صدى للرعب من كوباني والإيزيديين. الكسرة الرمزية مع سردية التحرر السوري المهيمنة هو أنّ يوم الثورة السورية، أي 18 آذار عام 2011، هو نفسه يوم احتلال مدينة عفرين في 18 آذار عام 2018. لا تهدف الإشارة للمفارقة إلى جوهرتها في أحاسيس منفصلة، بل هي ضرورة لإعادة تشكيل الحكاية بما يتضمّن أحاسيس الجميع. وهذا ربّما يتطلّب مستوى من التجريد وتجاوز النفس: 18 آذار هو يوم لا تنتهَك فيه كرامة أي أحد على الأراضي السورية ولا يُقتَل… من أي طرف كان.
لم يضيع أبو شيار الكثير من الجهد حول فكرة كردستان الكبرى، ولكن ثمّة تصوّر واضح عن السلوك السياسي البافلوفي الكردي السوري، الآلية التي تحرّك كلّ الطيف. الديناميكية هي أنَّ ضمور البعد الديمقراطيّ واللامركزي، وهيمنة السلطوية المركزية بمذاقاتها الإسلامية والقومية، ستفعِّل الوضعية الحمائيّة الكرديّة بالعودة إلى وضعية الصمت. ولكن الصمت هنا ثقيل يا أبو شيار. لم يعد الترقب مثلما كان عام 2004، بل هو في حالة قسد صمتٌ ذو نبرة عالية. لدينا الآن جنرال، بمعايير إدارته، يتحرّك بطائرة أميركيّة. في الحالتين، في الصمت الأعزل والصمت المدجج أميركياً، لا تزال حدود السياسة الكردية السورية تتحرّك بين نفيَيْن: لا نية مضمرة أو مخططة بالانفصال السياسي أو بالاستقلال الذاتي عن سوريا (للمرة المليون، لا يوجد أي حزب سياسي كردي يطالب بالانفصال)، ولا حماس في الانضمام إلى سلطوية مركزية بالنكهتَيْن المعروفتَيْن. هذا تحدّ.
مثلما يميل المهاجر في الغرب إلى الكونية الاندماجيّة لدرء خطر اليمين القومي، تميلُ السياسة الكرديّة السورية لكفة الوطنية الديمقراطية، الكونيّة المحليّة الممكنة سورياً، خوفاً من هيمنة المركزيّة السلطوية. الاتفاق مع قسد هو شعاع الضوء الذي أضاء حجم المشكلة. وحلها يكمن في تحويل قسد ليس إلى ضمانة لـ«محاربة الإرهاب» كما تسوّقها الدول الغربية، بل طاقة موازية تفرض ترجمة للنفس وإعادة تشكّل للمقيمين في قصر الشعب، للدفع باتجاه سوريا ديمقراطية تعددية. سوريا يديرها جيش خطابه وشعاراته ورموزه تحفّز الجميع، لأن الحد الأدنى ارتفع، والكل لا يريد العودة إلى وضع توضع فيه قماشة على طابعة أو تحرق المنشورات خوفاً من اكتشافها.
النضال الآن هو لسوريا لا أحد يشعر بالنقص فيها.
موقع الجمهورية
——————————————-
صفقةٌ في دمشق ما الدوافع الكامنة خلف الاتفاق المُبرم بين أكراد سورية وإدارة أحمد الشرع الجديدة؟
فلاديمير فان ويلغنبرغ
تحديث 21 أذار 2025
يوم العاشر من آذار/مارس، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقًا من ثمانية بنود، يقضي بدمج هذه القوات في الإدارة السورية الجديدة.
تفاجأ كثرٌ بتوقيت الاتفاق المُبرم مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يطغى عليها الأكراد، الأمر الذي يدفع المرء إلى التساؤل حول السبب الذي دفع الأكراد إلى توقيع هذا الاتفاق بعد فترة وجيزة جدًّا من اندلاع التمرّد المحلي الذي قاده فلول نظام الأسد السابق في مناطق الساحل السوري وريفها. وأسفر ذلك عن حملة قمع شرسة ضدّ أبناء الطائفة العلوية، ومقتل حوالى 800 شخص خارج نطاق القانون. لا بدّ من التساؤل: هل وقّع الأكراد الاتفاق بسبب احتمال انسحاب القوات الأميركية قريبًا من سورية، ما من شأنه أن يتركهم تحت رحمة القوات التركية؟ أم على العكس، هل اضطرّت دمشق إلى اتّخاذ هذه الخطوة سعيًا إلى التخفيف من الضرر الذي لحق بسمعتها بعد المجزرة التي ارتُكبت بحقّ العلويين؟ أم هل ثمّة أسبابٌ أخرى وراء توقيع هذا الاتفاق؟
تساءل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مقابلة مع شبكة ABC News، حول سبب عدم نجاح النظام السوري في التوصّل إلى اتفاق مع الأكراد إلّا بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها مناطق الساحل السوري. أبدى بعض المحلّلين السوريين خشيتهم من أن تدفع مجزرة العلويين الولايات المتحدة إلى الامتناع عن رفع العقوبات عن سورية، وبالتالي إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي في البلاد. في المقابل، تبنّى البعض الآخر نظرة إيجابية أكثر. فقد أبلغني وائل الزيات، وهو خبيرٌ سابقٌ في سياسات الشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية الأميركية، أن “هذا [الاتفاق] شكّل خبرًا سارًّا كان الجميع في أمسّ الحاجة إلى سماعه بعد أعمال العنف التي شهدناها في الساحل السوري”. وأضاف أن “السوريين يتنفّسون الصعداء في كلٍّ من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية على السواء”.
ولفت بدر ملّا رشيد، مدير مركز رامان للبحوث والاستشارات المُتَّخذ من اسطنبول مقرًّا له، إلى ورود توقّعاتٍ في وقتٍ سابق بشأن احتمال إبرام اتفاق، في 2 أو 3 آذار/مارس، لكن “بعد ذلك، تصاعدت وتائر الاشتباكات فجأةً في مناطق الساحل السوري”. وأضاف قائلًا: “أعتقد أن الطرفَين، إلى جانب الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة، مارست جميعها ضغوطًا على قوات سورية الديمقراطية ودمشق لتسريع عملية توقيع الاتفاق”.
لغاية الآن، تُبدي إدارة ترامب عدم ثقة بحكومة الشرع إلى حدٍّ كبير، مثلها مثل إسرائيل. فالعقوبات الأميركية المفروضة على سورية تسبّبت بتعطيل الدعم المادي الذي كانت ستقدّمه قطر إلى البلاد، على الرغم من أن القطريين أعلنوا في 13 آذار/مارس أنهم سيتمكّنون من تزويد سورية بالغاز الطبيعي عبر الأردن، لتوليد الطاقة الكهربائية. وقد أدان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قيام “إرهابيين إسلاميين متطرّفين” بقتل أشخاص من الأقليات الإثنية في [المناطق الساحلية في] غرب سورية. في هذا السياق، يمكن لإبرام صفقة مع قوات سورية الديمقراطية، حليفة الولايات المتحدة، أن تضمن لحكومة الشرع ربما الحصول على موافقة الغرب، ما يحسّن بالتالي صورة القيادة السورية الجديدة. وبالفعل، أشاد روبيو في 12 آذار/مارس بالاتفاق، على الرغم من إعرابه مجدّدًا عن قلقه إزاء “أعمال العنف الفتّاكة التي استهدفت الأقلّيات مؤخرًا”.
بدا أن آرون لوند، وهو زميل في مركز القرن الدولي، يتّفق مع هذا التفسير. فقد أخبرني أن “الحكومة السورية الجديدة تَعتبر من المهم عدم الدخول في مواجهةٍ مباشرةٍ مع قوات سورية الديمقراطية، إن كان بمقدورها تجنّب ذلك. فهي بحاجة إلى نسج علاقاتٍ بنّاءةٍ مع الولايات المتحدة لضمان رفع العقوبات، ناهيك عن حاجتها إلى الحصول على موافقةٍ أميركيةٍ لشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية”.
ثمة عاملٌ آخر أسهم ربما في التوصّل إلى اتفاق، وهو احتمال انسحاب إدارة ترامب من سورية. فقد ذكر حسن حسن، مؤسّس مجلة نيو لاينز، خلال مشاركته في جلسةٍ نقاشية نظّمها معهد الشرق الأوسط يوم 11 آذار/مارس، أن الأميركيين بدأوا بالفعل يدرسون سيناريوهات انسحاب قواتهم في أيلول/سبتمبر المقبل. ويُشار إلى أن وسيطًا أميركيًا كان حاضرًا خلال الاجتماع الأول بين الشرع وعبدي في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال حسن إن “الأميركيين كانوا إذًا منخرطين في مساعي التوصّل إلى اتفاق، إذ توسّطوا في هذه العملية خلال عهد بايدن، واستمرّوا [في ذلك] في ظل إدارة ترامب”.
وخلال الجلسة النقاشية نفسها، أشار تشارلز ليستر، زميلٌ أول في معهد الشرق الأوسط، إلى أن “الاتفاق كان في الأساس مطروحًا على الطاولة منذ أسابيع، وجرى الاتفاق على بنود شكّلت بنيته الأساسية”. ولفت أيضًا إلى أن “القوات الأميركية كانت منخرطة منذ اليوم الأول، والنتيجة التي وصلنا إليها كانت بفضل دفع قوي من الجيش الأميركي”. وذكر أن قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، تواجد مؤخرًا في شمال شرق سورية، وسط تقارير أفادت بأنه ساعد على حثّ قوات سورية الديمقراطية على المضيّ قدمًا بالاتفاق، حتى لو أن المفاوضات كانت تجري على قدم وساق من دونه.
وأبلغني آرون ستاين، رئيس معهد أبحاث السياسة الخارجية، أن “الولايات المتحدة كانت تضغط على مظلوم لتوقيع اتفاقٍ منذ فترة، لكنه كان يماطل. وأعتقد أن احتمال انسحاب الولايات المتحدة دفع مظلوم إلى حسم أن الوقت قد حان لاتّخاذ هذه الخطوة الأولى، وتمديد المفاوضات مع دمشق حول مستقبل سورية”.
كذلك، برزت مؤشرات على أن قوات سورية الديمقراطية سعت إلى إبرام اتفاقٍ من تلقاء نفسها. فيوم 18 شباط/فبراير، أعلن المسؤول في “قسد” أبو عمر الإدلبي أنه خلال اجتماع عُقد بينها وبين مؤسسات محلية، تقرّر دمج قوات سورية الديمقراطية ضمن هيكل الجيش السوري، وتشكيل لجانٍ لمعالجة القضايا الشائكة، بما فيها تسهيل عودة النازحين داخليًا إلى مدنهم وقراهم، وهذه نقاط أساسية تضمّنها الاتفاق الجديد مع دمشق. وفي 26 شباط/فبراير، ألمح عبدي إلى احتمال التوصّل إلى اتفاق خلال الأسبوعَين المقبلَين.
مع ذلك، نفى مصدرٌ من قوات سورية الديمقراطية أن يكون الاتفاق مرتبطًا بانسحابٍ أميركي محتمل. ولفت إلى أن “الولايات المتحدة لم تتّخذ قرارًا بشأن سياستها في سورية. ما من تغيير يطرأ. والمحادثات كانت مستمرة منذ فترة طويلة”. أما بالنسبة إلى الاشتباكات التي اندلعت في مناطق الساحل السوري، فقال المصدر عينه إن تزامُنَ الاتفاق مع هذه الأحداث “كان محض صدفةٍ”.
وفي 26 شباط/فبراير الماضي، دعا زعيم حزب العمّال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان عناصر حزبه إلى إلقاء السلاح في إطار تحقيق عملية السلام بين الحزب والحكومة التركية ووضع حدّ لصراعهما الدائر منذ أربعة عقود. وقد تسهم هذه العملية أيضًا في تحسين العلاقات بين تركيا وقوات سورية الديمقراطية، التي يتّهمها الأتراك بالارتباط بحزب العمّال الكردستاني. وقد دفع هذا التطوّر البارز بالمصدر المذكور (وهو من “قسد”) إلى القول إن “رسالة أوجلان شجّعت قوات سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سورية على تسريع عملية [الاتفاق مع دمشق]. وكانت الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا في الاتجاه نفسه، لذا لم ييعد ثمّة سببٌ يدعو إلى الانتظار “.
علاوةً على ذلك، صرّح صالح مسلم، المسؤول البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي، لصحيفة Türkiye بأن الحزب كان يُجري مفاوضات مع دمشق منذ فترة طويلة. والجدير بالذكر أن حزب الاتحاد الديمقراطي ساعد على تأسيس وحدات حماية الشعب، وهي الفصيل الرئيس في قوات سورية الديمقراطية. وأضاف قائلًا: “لم نجلس على الطاولة بتوجيهاتٍ أو بطلبٍ من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى. وقد نتّخذ قرارًا بانسحابنا من شمال شرق سورية، فنحن لا نبني خططنا على أساس الوجود الأميركي أو التحالف الدولي”.
ولفتت الباحثة سامنتا تيل من مركز معلومات شمال وشرق سورية، إلى أن “قسد” لا تتوقّع انسحاب القوات الأميركية في وقتٍ قريب. وأضافت أن “[الأكراد] يعلمون بالطبع أنها لن تبقى هناك إلى الأبد، وأن قوات سورية الديمقراطية جادّة برغبتها في إرساء السلام في سورية. هي فعلًا ترغب في تحقيق ذلك، لكي تُنتفى الحاجة إلى وجود قوات خارجية داخل البلاد”.
وفي ما يتعلق بدوافع الحكومة السورية، لفت تشارلز ليستر على ما يبدو إلى أنها مهتمّةٌ أيضًا بإبرام اتفاق. وأضاف أن وزير الدفاع السوري أشار إلى أن اللجوء إلى حلٍّ عسكري في وجه قوات سورية الديمقراطية كان ليتطلّب نشر جميع القوات العسكرية السورية في شمال شرق البلاد، وهو أمرٌ لم يكن ليحدث إطلاقًا. لذا، كان لدى دمشق سببٌ لتفضيل تطبيق حلٍّ تفاوضي، ولا سيما أن ما من اشتباكٍ سُجِّل بين قوات القيادة السورية الجديدة و”قسد” منذ كانون الأول/ديسمبر.
ويبدو أن وائل الزيات يشاطره هذا الرأي، إذ قال: “أعتقد أن قوات سورية الديمقراطية كانت ترزح تحت وطأة الضغوط، نظرًا إلى إمكانية انسحاب القوات الأميركية، و[كذلك] كانت الحكومة السورية التي لم تُرِد خوض صراع على جبهات متعدّدة”.
أما آرون لوند فألمح إلى احتمال وجود بعض المسائل الشائكة على الرغم من إبرام الاتفاق. فقد قال: “يبدو لي الاتفاق مُبهمًا للغاية، وأعتقد أن الشرع وعبدي أقدما على هذه الخطوة لأن إحراز بعض التقدّم على هذا المسار ملائمٌ سياسيًا. ولا يظهر أنهما تمكّنا من تسوية النقاط الشائكة الرئيسة، أو على الأقل ما من مؤشرات على ذلك في الاتفاق المُعلَن”.
في الواقع، لا يوضح الاتفاق ما إذا كانت منطقة شمال شرق سورية ستشكّل جزءًا من هيكل سوري يستند على اللامركزية بشكل أكبر، أم أنها ستتمتّع حتى بحكم ذاتي، فيما يُعرف عن السلطات في دمشق ميلها إلى المركزية. ومن بين الأسئلة التي بقيت عالقةً أيضًا: هل سيتم تكريس حقوق الأكراد في الدستور السوري؟ وهل سيتم حلّ قوات سورية الديمقراطية أم سيجري دمجها كوحداتٍ منفصلة في منظومة الدفاع الجديدة؟ وهل ستتماشى السياسات الكردية التي تضمن المساواة بين الجنسَين مع النظام القانوني السوري، المتأثّر بالشريعة الإسلامية؟ تُضاف إلى ذلك أيضًا مسألة من سيسيطر على حقول النفط والغاز في سورية. كلّ هذه الثغرات تشير إلى الحاجة إلى إجراء مفاوضات مطوّلة، حتى لو أن الاتفاق قد نصّ على مهلة تطبيقٍ للبنود تنتهي في موعدٍ أقصاه نهاية العام الجاري.
سورية
لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.
مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط
——————————-
التفاوض بين دمشق و”قسد”: خطوات جديدة ومسارات معقدة/ ماهر الحمدان
2025/03/20
في تطور جديد على صعيد العلاقة بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، عقد قائد الأخيرة مظلوم عبدي، اجتماعاً مع اللجنة التفاوضية التي شكّلها الرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار استكمال الاتفاق بين الطرفين. ووفقاً لما نشرته “قسد” عبر منصاتها الرسمية، تناول الاجتماع عدة ملفات محورية، من أبرزها الاعلان الدستوري، ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوري من مستقبل البلاد، وأهمية وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية. كما تطرقت المناقشات إلى آلية عمل اللجان التخصصية، التي من المقرر أن تباشر مهامها في الأول من نيسان، تمهيداً لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
وفي هذا السياق، صرّح حسين السلامة، رئيس اللجنة التفاوضية المكلفة من الرئيس السوري، بأن اللجنة، التي تضم خمسة أعضاء، تم تشكيلها عقب التوصل إلى اتفاق مع “قسد”، وتوجه أعضاؤها إلى الحسكة للقاء قائدها. وأوضح أن الاجتماع الأول سادته أجواء إيجابية، بحيث أبدى الطرفان جدية واضحة في المباحثات، وتم الاتفاق على تحديد موعد جديد في بداية الشهر المقبل لتشكيل لجان تخصصية تتولى تسلم الملفات المختلفة، تمهيداً للاندماج التدريجي لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
تحذيرات ومخاوف من المماطلة في تنفيذ الاتفاق
وأشار السلامة الى أن اللجنة باشرت أعمالها بزيارة أحد مقار “قسد” في الشدادي، حيث التقت قائدها مظلوم عبدي، في اجتماع اتسم بالمسؤولية الوطنية، وبإرادة مشتركة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مع إشراك جميع المكونات من دون إقصاء أحد. وأضاف أن النقاشات أفضت إلى اتفاق على تشكيل لجان عمل تخصصية متناظرة ستباشر مهامها مع بداية نيسان المقبل، مؤكداً تقدير الحكومة السورية للدول الصديقة الداعمة لوحدة سوريا واستقرارها. كما شدد على أن الوضع في دير الزور والرقة والحسكة هو شأن داخلي سوري، وأن أي نقاش حول هذه المناطق يندرج ضمن المسار الوطني البحت، نافياً صحة الأنباء المتداولة بشأن اجتماعات جانبية مع أطراف أخرى. وأكد أن جهود اللجنة تتركز على تقريب وجهات النظر وصياغة خريطة طريق لتوحيد الأراضي السورية ضمن إطار المصلحة الوطنية.
وفي هذا الاطار، قال الدكتور فاروق الابراهيم، رئيس حركة الإصلاح والتغيير في دير الزور، لموقع “لبنان الكبير”: “ننتظر تنفيذ بنود الاتفاق الواضحة، فمن الضروري أن تعود دير الزور والرقة إلى أبنائها العرب، ولا ينبغي تأخير تنفيذ هذه البنود. هناك أعداد كبيرة من المهجرين من أبناء المنطقة، سواء داخل سوريا أو خارجها، يتطلعون إلى العودة. نحن ندعم جهود اللجنة بصورة كاملة، لكننا نحذر من أي محاولات للمماطلة أو تمييع عمل اللجنة، فهناك مراحل واضحة يجب الالتزام بها من دون أي تهاون.”
وأشار مصدر لموقع “لبنان الكبير” إلى أن التكهنات حول مخرجات الاجتماع وآلية انضمام “قسد” ليست دقيقة، موضحاً أنه لن يتم الاعلان عن أي قرارات ملموسة قبل انتهاء عمل اللجان، التي ستباشر مهامها رسمياً في بداية نيسان. كما أكد أن العملية تتطلب وقتاً، بحيث يجري العمل وفق آلية تدريجية قد تؤدي إلى دمج “قسد” ككتلة واحدة أو كأفراد ضمن مؤسسات الدولة. ولفت المصدر إلى أن هناك ملفات متعددة ذات أهمية، أبرزها عودة المهجرين إلى مناطقهم، تحديد آليات الادارة المدنية، تعزيز قوى الأمن الداخلي، وتنظيم ملف الثروات النفطية، وهي جميعها قضايا يجب التعامل معها بحذر.
حوار كردي-كردي برعاية أميركية وفرنسية
بالتوازي مع هذه التطورات، عقد “المجلس الوطني الكردي” في سوريا اجتماعاً مع حزب “الاتحاد الديموقراطي”، الثلاثاء، في قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة، بهدف توحيد الصف الكردي وصياغة رؤية سياسية مشتركة. وحضر اللقاء، الذي يُعد الأول بين الطرفين منذ العام 2020، المبعوث الأميركي الخاص لمناطق شمال وشرق سوريا، سكوت بولز، إلى جانب قائد “قسد”.
وركز الاجتماع على مناقشة الرؤية السياسية المشتركة بين الجانبين وآلية تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق. وأشار المصدر إلى أن الأجواء كانت إيجابية، بحيث أبدى الطرفان رغبة متبادلة في إنجاح الحوار، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط الأميركية والغربية لدفع الجانبين نحو اتفاق مشترك. ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن تشكيل الوفد خلال الشهر الجاري، اذ سيجتمع مع الحكومة السورية في دمشق برعاية ودعم من وزارتي الخارجية الأميركية والفرنسية، بهدف صياغة رؤية موحدة للتفاوض مع دمشق. كما أكد المصدر أن أكثر من 90% من بنود الرؤية السياسية تم التوافق عليها، مع استمرار النقاشات حول بعض البنود الثانوية المتبقية.
ضغوط دولية ودعم أميركي وفرنسي للمفاوضات
يحظى الحوار بين الأطراف الكردية بدعم واسع من الخارجية الأميركية، التي تؤكد أن واشنطن، إلى جانب دولة أخرى، تمثل موقف “التحالف الدولي” الداعم لتوحيد صف الأكراد السوريين تمهيداً للحوار مع دمشق. وفي شباط الماضي، تم الاتفاق بين “المجلس الوطني الكردي” وقائد “قسد” على تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض مع الحكومة السورية، بعد سلسلة لقاءات تمت برعاية وزارتي الخارجية الأميركية والفرنسية.
كما سبق أن عُقد اجتماع بين الهيئة الرئاسية للمجلس وقائد “قسد”، بحضور ممثل وزارة الخارجية الفرنسية، ريمي داروين، والمبعوث الأميركي بولز، في قاعدة استراحة الوزير شمال غربي الحسكة. ووافق “المجلس الوطني الكردي” على لقاء حزب “الاتحاد الديموقراطي” بهدف تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع مسؤولي الادارة السورية الجديدة وبحث المطالب الكردية.
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب بين المجلس الوطني الكردي وحزب “الاتحاد الديموقراطي” بعد قطيعة دامت أكثر من أربع سنوات، تخللها تصعيد إعلامي وتوترات بين الطرفين، وسط اتهامات لحزب الاتحاد بارتكاب انتهاكات ضد المجلس وأعضائه.
موقع لبنان الكبير
———————————
=====================
===========================
عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 21 أذار 2025
تحديث 21 أذار 2025
——————————-
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
———————————
“الورقة” الدرزية/ زياد بركات
20 مارس 2025
أسوأ ما يمكن أن يحدُث للسوريين الدروز أن يصبحوا مجرّد ورقةٍ في لُعبة أكبر منهم، والأسوأ في ما يخص المنطقة بأسرها أن تنجح إسرائيل في تحويل دروز العالم، وليس في سورية فقط، قوميةً وليس أقلّيةً دينية، وهو ما حذّر منه قبل أيام الزعيم اللبناني الدرزي، وليد جنبلاط، في ذكرى اغتيال والده.
ومعلوم أن إسرائيل وباكستان هما الوحيدتان في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية اللتان تحوّلتا دولتين و”قوميَّتين” على أساس ديني لا عرقي، وستظلّان حالةً شاذّةً رغم أنهما نجحتا في ذلك، لكن هذا يُفسّر (من بين أسباب أخرى أكثر تعقيداً) عزل إسرائيل منذ الدقيقة الأولى دروز فلسطين عن بقيّة سكّانها، ووضع الخطط لتجنيدهم في جيشها، بالترهيب حيناً والإغراءات أحياناً أخرى، وبدفع قوي وخطط متدرّجة وضعها ديفيد بن غوريون نفسه.
وإذا كانت قد نجحت في هذا، في حالة شعبٍ يرزح تحت أسوأ احتلال وأطوله في التاريخ المعاصر، فهذا لا يعني نفاذ خططها بخصوص السوريين الدروز في أيامنا هذه، فثمّة فرق بين الهواجس والمخاوف المضخّمة، جرّاء عقود من المظلوميات التي خلّفها وراءه نظام آل الأسد، وهي تشمل دروز سورية وسُنّتها وعلوييها، وحتى معمارها وأزقّتها الضيّقة إذا شئت، ونقل هذه المظلومية إلى منطقة أخرى خارج التيّار العامّ لنضالات السوريين في عمومهم، للوصول إلى دولةٍ حديثةٍ ومعاصرةٍ تقوم على مفهوم المواطنة، وهو ما تيسّر بفرار المخلوع الذي بطش بدروز بلاده واستغلّهم ووظّفهم، واغتال من اغتال منهم، ممّن رفضوا الاندراج في خططه القائمة على تخويف الجميع من الجميع لينتهي كلّ القمح إلى بيادره هو.
وما تُعنى به إسرائيل عملياً، وبعيداً من أيّ أوهام قد تراود بعض السوريين، من دروز أو سواهم، هو إقامة مناطق عازلة، جدران من نار تعزلهم عن خطرٍ تراه محدقاً حتى لو بعد ألف عام، ومن شأن تحريض السوريين الدروز (وهذا مستبعد) إنشاء كانتون عازل في حدودها مع سورية، ولكن فكرةً كهذه يكتنفها كثير من التعقيدات، خاصّة أنها قد تعني وضع اليد على محافظة بحجم درعا ومساحتها، وهي بلغة الأقلّيات سُنّية، وتتفوّق عدداً على المناطق الدرزية كلّها، بلغة الأقلّيات ومنطقها (المرفوض في كلّ حال وتحت أيّ ظرف)، وهو ما يُشكّل خطراً على دول المنطقة وأمنها، خصوصاً الأردن ولبنان وتركيا، فأيُّ لعبٍ بالخرائط يفتح صندوق باندورا، حيث الشرور لا تعرف صديقاً.
ثمّة مشكلات كُبرى في سورية ما بعد المخلوع، منها الأوضاع الاقتصادية، وثلاثة أرباع ما يؤرّق دروز السويداء السوريين هو تدهور أوضاعهم المعيشية، وهو ما سبّب تحوّل مواقف بعض قادتهم في السنوات الماضية لحكم الأسد، ومنهم الشيخ حكمت الهجري نفسه، الذي كان مؤيّداً، وآخرون ممّن كانت مخاوفهم من “الجماعات المسلّحة” تتقدّم لديهم على معارضتهم الأسد.
ومع غياب الأخير، الذي يقيم في جنّة المنفى الروسي، وليس في سجون بناها نظامه، ومجيء نظام جديد، فإن من شأن تحسّن الأوضاع الاقتصادية، وقيام العهد الجديد بتبديد المخاوف جدّياً، قطع الطريق على مخطط كبير لا يوجد، حتى اللحظة، درزيٌ واحدٌ يتمتّع بتاريخ شخصي يُعتّد به مستعدّ للقبول به.
ما تحتاج إليه سورية ورشة طمأنة كبيرة وشاملة، وقطيعة مع ذهنية الأقلّيات نفسها، التي قد تهدر فرصة بناء سورية أخرى، معافاة، قوية، ذات وزن في المنطقة، بما تزخر به من طاقات وإبداعات قلّ نظيرهما. والمأمول أن تنجح سورية في ذلك على صعوبته، خاصّة أن العهد الجديد “طرفٌ سابق”، وصحيحٌ أنه ناضل وكافح وقاتل نظام الأسد، لكنه كان أيضاً جزءاً من مصادر مخاوف بعض السوريين من مستقبل صعب ينتظرهم، وهو ما استثمر فيه نظام الأسد الذي وضع السوريين أمام معادلة نظامه أو الإرهاب، ودفع كثيرين من معارضيه إلى العضّ على أسنانهم الدامية والركون إلى الصمت، ومن بين هؤلاء سُنّة وشيعة ودروز وعلويون ومسيحيون، ونحن نتحدّث هنا عن مواطنين دفعهم النظام إلى قتل بعضهم بعضاً، وخوف بعضهم من بعض، وفخّخ حتى أحلامهم بمخاوف تنهار بين ليلة وضحاها لو أقلعت السفينة وتحسّنت أوضاع الناس، وتمتّع الحكم ببعض الرشد ليس أكثر، والظنّ أنه يسعى ويفعل.
العربي الجديد
—————————
سوريا… احتدام التنافس بين أجندات الخارج والداخل/ إبراهيم حميدي
ترمب يتوقع التقسيم وإسرائيل تريد “فيدرالية” وإيران تدفع إلى “التشظي”… والدول العربية تريد الاستقرار
19 مارس 2025
الرئيس دونالد ترمب قال في جلسة مغلقة، إن سوريا “ماضية إلى التقسيم لثلاث مناطق”. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث علنا عن “حماية الدروز”، وروج آخرون في حكومته لسيناريو “الفيدرالية”. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد دعم “وحدة سوريا” و”محاربة الإرهاب” ومنع قيام كيان كردي.
إيران، من جهتها، لم تقبل الهزيمة الاستراتيجية في سوريا. امتصت الصدمة وقررت التحرك فيها عبر “ثلاث جبهات”، فيما قبلت روسيا بتقليل خسائرها والبحث مع دمشق عن علاقات جديدة تتضمن استمرار وجودها العسكري ونفوذها في البلاد والإقليم.
أما الدول العربية والأوروبية، فقررت الانخراط مع الإدارة السورية الجديدة، لأن “دعمها أقل كلفة من أي بديل آخر”، وهي تريد الاستثمار في المكاسب الجيوسياسية، المتعلقة بخسارة إيران وروسيا، لأن أمن سوريا يتعلق بأمنها واستقرار الإقليم.
هذه خلاصة تقديرات ومعلومات من مسؤولين غربيين تحدثوا إلى “المجلة” خلال الأيام الماضية.
أميركا: التقسيم
في الأيام الأخيرة لإدارة جو بايدن، فتحت بابا للحوار مع الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتقت المسؤولة في الخارجية باربرا ليف، رئيس الإدارة أحمد الشرع في دمشق، وواصلت اتصالات غير معلنة قام بها دبلوماسيون أميركيون مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، كما خففت بعض العقوبات عن قطاعات سورية لمدة ستة أشهر.
منذ مجي إدارة دونالد ترمب، تشير المعلومات إلى وجود اتجاهين:
الأول، يرفض الانخراط مطلقا مع دمشق ويستند في موقفه إلى بُعد أيديولوجي يتعلق بـ”القاعدة”، أو تجارب شخصية تخص حرب العراق وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 أو بسبب علاقة شخصية مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مثل مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد. كما يرفض أصحاب هذا الرأي العمل مع الجيش السوري الجديد لمحاربة “داعش” ضمن التحالف الدولي وقيادة عملية “العزم الصلب”.
الثاني، مستعد لـ”انخراط مشروط” وفق مقاربة “خطوة مقابل خطوة”، عبر إقدام دمشق على سلسلة من خطوات تشمل: تشكيل حكومة جامعة، تشكيل جيش مهني حرفي، إبعاد المقاتلين الأجانب، تدمير برنامج السلاح الكيماوي والتدمير الشامل، محاربة “داعش”، التمسك بإبعاد إيران خارج سوريا، قطع طريق الإمداد إلى “حزب الله”، عدم الموافقة على استمرار وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين.
في المقابل، تعرض واشنطن استعدادها لخطوات تشمل تخفيف العقوبات على قطاعات محددة في شكل تصاعدي وصولا إلى رفع كامل للعقوبات و”قانون قيصر” في نهاية المطاف بعد حوالي أربع سنوات، علما أن قائمة العقوبات الأميركية تشمل “قانون قيصر” و”قانون محاسبة سوريا” و”دعم الإرهاب”، ويعود بعضها إلى عام 1979، إضافة إلى عقوبات فردية ضد مسؤولين في النظام السابق وشخصيات حالية أخرى.
سوريا ليست أولوية على أجندة ترمب. وتجري حاليا مراجعة داخل المؤسسات الأميركية وصولا إلى سياسة موحدة إزاء سوريا. ونُقل عن ترمب قوله في اجتماع خاص إن سوريا ستقسم إلى ثلاث مناطق تابعة لقوى خارجية مثل إسرائيل وتركيا وغيرهما، وإنه لا بد من محاربة “الإرهاب”، مع تلميح إلى إمكانية الانسحاب من شمال شرقي سوريا، الأمر الذي دفع وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى إعداد خطط للانسحاب في ستة أشهر، ودعمها بقوة لقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي للوصول إلى حل تفاوضي مع الرئيس أحمد الشرع خلال ذلك.
إسرائيل: فيدرالية
يراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التأثير على ترمب وفريقه، بحيث تكون حسابات تل أبيب ذات أولوية في البيت الأبيض الذي لا يدرج سوريا ضمن أولوياته في الشرق الأوسط. بالفعل، جرت مناقشات بين أجهزة إسرائيلية وأخرى أميركية حول هذا الملف، مع ترجيح رأي تل أبيب في شؤون جارتها.
نتنياهو يعتبر سوريا أولوية له هي والأمن القومي وإبعاد ايران. فالجيش الإسرائيلي قام بمجرد سقوط الأسد بتدمير جميع الأصول العسكرية الاستراتيجية السورية، البرية والجوية والبحرية والبرامج العلمية والصاروخية. كما احتل المنطقة العازلة في الجولان بموجب اتفاق “فك الاشتباك” لعام 1974. وسيطر على قمة جبل الشيخ ومنابع المياه في المنطقة. وشن سلسلة غارات في جنوب سوريا ووسطها لمنع بناء أصول استراتيجية دفاعية سورية.
إضافة إلى ذلك، تتخذ إسرائيل موقفا عدائيا ضد الحكم السوري الجديد، وهي تدفع باتجاه إقامة “فيدرالية” أو “لامركزية واسعة” في سوريا، تشمل إقليما جنوبيا يتضمن السويداء ودرعا، وشرقيا يشمل “قوات سوريا الديمقراطية”، وغربيا يتضمن إقليما علويا، بحيث يبقى الإقليم العربي-السني الأكبر معزولا عن جواره وفضاءات المياه الدافئة.
جرت اتصالات سرية حول هذه الأمور في واشنطن وعواصم إقليمية. ويدفع نتنياهو بقوة لإقناع ترمب وفريقه بهذا التصور، الذي هو موضع قلق عربي وتركي ومواكبة إيرانية غير مباشرة ومتابعة روسية، كما هو محل مواكبة أوروبية مع ترجيح للمقاربة البريطانية.
روسيا: تقليل الخسائر
عندما أدرك الرئيس فلاديمير بوتين قرب نهاية بشار الأسد الذي تمرد مرات عدة على طلباته- وكان آخرها رفضه لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بناء على مبادرة الكرملين- رتب مع نظيره التركي الانخراط في الأيام الأخيرة من نظام الأسد لتقليل الخسائر الروسية الاستراتيجية وتجنيب دمشق والموالين للنظام الخراب والانتقام.
بالفعل جرى الانتقال بأقل كلفة للمدن والبشر والموالين للنظام، ولم تتعرض القاعدتان الروسيتان، في حميميم وطرطوس، لأي هجمات من النظام السوري الجديد. كما صدرت تصريحات من المسؤولين السوريين الجدد تتحدث عن العلاقة القديمة مع روسيا واحترام مصالحها باعتبارها دولة كبرى.
زار ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي دمشق والتقى الرئيس الشرع الذي تلقى اتصالا معلنا من بوتين وآخر غير معلن. تتناول المحادثات السورية–الروسية نقاطا عدة: التزود بالسلاح الروسي، تسلم بشار الأسد وكبار المسؤولين المتهمين بجرائم حرب، مستقبل القاعدتين الروسيتين، المساهمة في إعمار سوريا، تقديم المساعدات والأموال السورية المطبوعة تعويضا عن مساهمة روسيا في قمع الشعب السوري، الديون الروسية لسوريا.
بوتين أبلغ دمشق رسالة واضحة بأنه لن يسلم الأسد إلى دمشق، لأنه “قال كلمته وقدم له لجوءا إنسانيا”، كما أنه لم يقبل فكرة أن “ينتحر الأسد على الطريقة الروسية”، لكن موسكو أبدت انفتاحا لتقديم السلاح والمساهمة في الإعمار وسحب قواتها “فورا إذا أرادت دمشق”. كما أبدت دمشق انفتاحا لبحث وجود عسكري روسي في سوريا. والمفاوضات جارية وتتناول هذه البنود والمقايضات.
في هذا السياق، حصل تطوران: الأول، أن تل أبيب سعت لدى واشنطن لتأييد استمرار الوجود الروسي لـ”موازنة النفوذ التركي” في سوريا. والثاني، تمرد فلول النظام السوري في الساحل، حيث اتخذت موسكو موقفا يسمح لها باستخدام هذا التمرد ورقة ضغط على دمشق وورقة تسمح لها بترك الخيارات مفتوحة في حال أقيم إقليم علوي.
إيران: التشظي
لم تقبل طهران الواقع الجديد بفقدان سوريا بعد لبنان، فهي خسرت طريق الإمداد إلى “حزب الله”، والحديقة الخلفية للعراق، وأداة الضغط على إسرائيل عبر جبهتي لبنان وسوريا. كل المؤشرات تشير إلى تفضيل إيران خيار “التشظي السوري” والرهان على الوقت، لاستعادة موطئ قدم في سوريا. عليه، بدأت في الفترة الأخيرة بعد اجتماعات سرية عدة تحريك أوراقها لفتح ثلاث جبهات:
الأولى، استعادة علاقات مع مسؤولين في النظام السوري السابق كان بينهم العميد غياث دالا، الذي كان يقود “قوات الغيث” في “الفرقة الرابعة” بقيادة اللواء ماهر، شقيق بشار الأسد، وكان ضابط الارتباط مع “الحرس” الإيراني و”حزب الله”. ماهر الأسد نفسه هرب مع قادة ميليشيات تابعة لإيران في 8 ديسمبر/كانون الأول إلى العراق، وقيل إنه انتقل إلى السليمانية في كردستان العراق. ومن غير المؤكد مكان وجوده الحالي. كانت أيادي إيران واضحة في تمرد الساحل الأخير، بالدعاية والتدريب والمعلومات.
الثانية، الضغط على “الحشد الشعبي” العراقي للتحرك نحو الحدود السورية. وإيران تريد تعزيز وجودها في العراق بعد خسارات “الهلال” في بلاد الشام، وتريد استخدامه في الملعب السوري. أيضا، يجري تداول سيناريو عودة “داعش” للنشاط في الأنبار وغربي العراق والتوغل نحو البادية السورية.
الثالثة، الضغط على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وتحريك عشائر عربية شرق الفرات، للتنسيق والعمل العسكري ضد الإدارة السورية الجديدة. قائد “قسد” نفى ذلك في حديثه إلى “المجلة”. وقال: “لن يكون هناك مستقبل لعلاقات مع إيران. ونحن حاليا نركز على أن نكون جزءا من الإدارة الجديدة وجزءا من المحادثات السياسية لا أن نكون معارضة كما يتهمنا البعض”. كما وقع اتفاق مبادئ مع الرئيس الشرع في دمشق يوم 10 مارس/آذار بعد جهود أميركية وفرنسية مكثفة.
تركيا: مع الوحدة ضد كيان كردي
لم يكن أردوغان مرتاحا كثيرا لاتفاق الشرع-عبدي. الاتفاق كان موجودا على طاولتيهما منذ لقائهما في 29 ديسمبر، لكن تمرد الساحل والانتهاكات فيه من جهة، وحديث الأميركيين السري عن احتمال الانسحاب بعد ستة أشهر من جهة ثانية، وتفاهم زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبدالله أوجلان مع أنقرة من جهة ثالثة، دفعت الشرع وعبدي لتلبية جهود أميركية-فرنسية، وتوقيع اتفاق يحتاج تنفيذه إلى الكثير من التفاوض وخريطة طريق، هي في قبضة مساعديهما. مظلوم حق نجاحا بأنه “فتح باباً رئاسياً لمناقشة حقوق الأكراد لأول مرة في التاريخ”. والشرع، فتح باباً سورياً لحياكة الخريطة السورية بعد أكثر من عقد من التآكل.
تركيا تدفع إلى تنفيذ مبادئ الشرع-عبدي، وهي: منع وجود “الإدارة الذاتية” وأي كيان كردي، وانضواء شمال شرقي سوريا ضمن سوريا الموحدة، وتفكيك البنية العسكرية الثقيلة لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية، وطرد قادة “حزب العمال الكردستاني” الموجودين في قيادة “الوحدات”.
وتسعى تركيا للإفادة من علاقتها مع “هيئة تحرير الشام” والشرع للدفع باتجاه تعزيز نفوذها في سوريا والإقليم في النواحي التجارية والعسكرية والسياسية والجيوسياسية. فسوريا تاريخيا بوابة تركيا إلى العالم العربي. لكن هذا النفوذ هو مصدر قلق لدول أخرى بينها دول عربية فاعلة.
الدول العربية: استقرار سوريا ووحدتها
منذ سقوط الأسد، بادرت دول عربية كبرى لدعم النظام الجديد وفتح صفحة جديدة معه، لأسباب عدة، بينها: البناء على الخسارة الاستراتيجية الأكبر لإيران منذ 1979. تخفيف اعتماد النظام السوري الجديد على تركيا. الحوار والانخراط والدعم لسوريا الجديدة وإعطائها الفرصة، لأن البديل سيئ جدا، والفوضى في سوريا مضرة والتقسيم خطير على الدول المجاورة والأمن الإقليمي العربي.
اكتشفت دول عربية حدود التحرك والدعم. لا يزال سيف العقوبات مسلطا. أميركا وافقت على تسهيل إمداد سوريا بالغاز لصالح توفير الكهرباء وسمحت بصفقة تتضمن مقايضة إعفاءات مقابل الوصول إلى السلاح الكيماوي السوري، لكنها لا تزال ترفض السماح بتحويلات مالية كبرى والانفتاح على النظام المصرفي السوري. هناك إصرار على ترك هامش الوقت لدمشق وتقديم النصيحة وليس الضغط والتحاور مع واشنطن ودول أوروبية لاعتماد أفضل الخيارات الواقعية حاليا في سوريا.
الأجندة السورية وجرس الإنذار
ما حصل في الساحل السوري بين 6 و10 مارس/آذار، سواء التمرد أو الانتهاكات الكبيرة، كان بمثابة جرس إنذار. فقد أظهر أهمية المفاجأة التي حصلت في 8 ديسمبر، إذ سقط نظام الأسد بعد 54 سنة من دون كلف دموية كبيرة بفضل التزام العناصر في “هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى بتعليمات القيادة العليا.
لكنه أظهر في الوقت نفسه، أسئلة حول سلسلة القيادة من فوق إلى أدنى، ومدى التزام المقاتلين أو الفصائل بالتعليمات، وطرح أسئلة في عواصم أوروبية عن “حماية الأقليات”، ودفع باريس إلى تأجيل توجيه دعوة لزيارات رفيعة لمسؤولين سوريين وعواصم أخرى لتجميد إعادة فتح سفاراتها لأسباب أمنية. إضافة إلى ذلك، كان بمثابة ناقوس خطر لما يمكن أن يحصل في حال عمت الفوضى. فتشظي سوريا يعني تطاير الشظايا والجهاديين في الإقليم وما وراءه.
برزت مشكلة تسريح عناصر الجيش والأمن والشرطة وموظفي القطاع العام، وتوفير الخدمات والكهرباء. فأصبح الملف الاقتصادي الاجتماعي أولوية للحكم الجديد. فالعقوبات لم ترفع والمساعدات الدولية تراجعت والتوقعات الشعبية زادت. قد يكون أحد الحلول طبع أموال جديدة، وتنفيذ هذا في موسكو. قد يكون الرمق في مساعدات عاجلة، لكنها قليلة طالما أنها عينية مرتبطة بالنظام المصرفي الغربي. ولا تزال الجالية السورية وحلفاء دمشق العرب والإقليميون، يعملون لدى واشنطن لرفع العقوبات وتخفيف معاناة الناس، لأنه دون ذلك، فإن تأثير رفع العقوبات الأوروبية والبريطانية والكندية سيكون محدودا جدا.
وأظهر المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل يوم 17 مارس/آذار، الدعم الأوروبي المستمر للسوريين، حيث أعلن عن تعهدات مالية بقيمة ستة مليارات دولار أميركي. فمنذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 37 مليار يورو من المساعدات داخل البلاد وفي المنطقة.
لكن الأهم أن المؤتمر أظهر، أن دعم الحكم السوري الجديد سيكون أقل كلفة من أي خيار آخر، بما في ذلك خيار عزله. وواصلت فرنسا جهودها لحشد المجتمع الدولي، تماشيا مع مؤتمر باريس في 13 فبراير/شباط، لإيجاد حلول دائمة وتوفير الاحتياجات الأساسية. كما جددت رسالتها إلى السلطات السورية بضرورة محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن العنف ضد الضحايا المدنيين في الأسابيع الأخيرة.
مقابل الأجندات الخارجية، هناك أجندة سوريا وخيوط سورية. وباعتبار ما حدث في الساحل كان جرس إنذار واختبارا كبيرا، فإن الشرع رد عليه بسلسلة خطوات برغماتية انفتاحية تمثلت في تشكيل لجنة تحقيق ولجنة للسلم الأهلي وإعلان دستوري. هناك انقسام حول هذه الخطوات. البعض قابله بالترحيب، فيما شكك آخرون فيها وطرحوا أسئلة عن ضرورة أن تكون الخطوات جامعة وأن تكون الخطوط مفتوحة في الاتجاهين بين المركز والأطراف.
أجندة دمشق هي رفض التقسيم ورفض الفيدرالية والعمل على بناء جيش وطني وحكومة ومؤسسات دولة وتعميم السلم الأهلي. واتفاق الشرع–عبدي، كان يعني في أحد جوانبه، إعطاء أولوية للأجندة الوطنية. هناك خطوات منتظرة ومتبادلة بين المركز وجهات الجنوب والشمال والغرب، لقطع الطريق على الأجندات الخارجية المتنافسة. وهناك أجندات خارجية متنافسة على مستقبل سوريا. عمليا، يحتدم الصراع بين أجندات الخارج وأجندة الداخل، ولكل أدواته وتحالفاته وإمكاناته ومواقيته.
المجلة
——————————-
تصعيد إسرائيلي متعدد الجبهات في سوريا.. فرض أمر واقع أم مواجهة مفتوحة؟
2025.03.20
تواصل إسرائيل عدوانها العسكري جنوبي سوريا، براً وجواً، LستهدTM القدرات العسكرية للدولة السورية، إثر الإطاحة بنظام بشار الأسد، حامي حدودها البرية الشمالية لعقود من الزمن. ومنذ الساعات الأولى لسقوط النظام، وفي الوقت الذي كان به السوريون يحتفلون برحيل الأسد، فتح الاحتلال الإسرائيلي الباب لسلسلة من الغارات الجوية التي تضرب منذ ذلك الوقت مواقع وقدرات ومعدات عسكرية سورية، وأحدث هذه الضربات جاء في 17 من آذار، حين نفذت غارتين جويتين على حي مساكن الضاحية القريب من “اللواء 132” في مدينة درعا، ما أوقع ثلاثة قتلى و19 مصاباً.
وقبل أيام من هذه العملية، هاجمت إسرائيل بمشاركة 22 طائرة وباستخدام 60 نوعاً من الذخيرة، رادارات ووسائل رصد مستخدمة لبلورة صورة استخباراتية جوية، ومقار قيادة ومواقع عسكرية تضم وسائل قتالية وآليات عسكرية للنظام السوري المخلوع، جنوبي سوريا، وفق ما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.
تحركات إسرائيل في سوريا لم تقتصر على الجو، فمنذ رحيل الأسد، تقدّم إسرائيل خطاباً سياساً معادياً للإدارة السورية الجديدة، إذ وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 9 آذار، الرئيس السوري، أحمد الشرع، بأنه “إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع بحق السكان المدنيين العلويين”.
الوزير نفسه، قال في 27 شباط، إن إسرائيل لا تثق بالإدارة السورية الجديدة، وإن الشرع “استبدل سرواله بالبدلة، وهو يتحدث بشكل جيد”، لكن إسرائيل تثق بجيشها فقط.
وجاء هذا التصريح بعد يومين من هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، للحكومة السورية، ووصفه لها بأنها “جماعة جهادية من إدلب استولت على دمشق بالقوة”، وأضاف، “الإسلاميون يتحدثون بشكل لطيف، لكن الحكومة السورية الجديدة تنتقم من العلويين وتلحق الأذى بالأكراد، لن نتنازل عن أمننا على الحدود”.
وتتعارض هذه التصريحات الإسرائيلية مع نصائح أميركية وجهها مسؤولون كبار في إدارة ترمب لإسرائيل، للامتناع عن إطلاق تصريحات ضد الإدارة السورية الجديدة، في سبيل عدم زيادة التوترات والضغوط الداخلية الإسرائيلية في الوقت الذي يبدي به الرئيس السوري عدم اهتمام ببدء صراع مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، تتوغل القوات الإسرائيلية براً في جنوبي سوريا، وتحديداً في القنيطرة التي وصل الإسرائيليون إلى مركز محافظتها، وفي درعا التي تفتش قوات الاحتلال منازل السكان المدنيين في أريافها.
وقبل أيام كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، عن خطة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في سوريا لتغيير الواقع في كل الشرق الأوسط، وتتضمن توسيع المنطقة العازلة على الحدود بعمق 80 كيلومتراً داخل سوريا، وليس بعيداً عن العاصمة السورية دمشق، مع عدم السماح بإدخال أسلحة إلى المناطق القريبة من الحدود.
وزير الدفاع الإسرائيلي من جانبه، وجّه تهديداً حاد اللهجة للرئيس السوري، وقال، “عندما يفتح الجولاني (في إشارة للرئيس السوري) عينيه في القصر الرئاسي في دمشق كل صباح، سيرى بأن الجيش الإسرائيلي يراقبه من قمة جبل الشيخ”.
النوايا الإسرائيلية تجاه سوريا ليست مضمرة، إذ تعلنها إسرائيل صراحة أن قواتها ستبقى إلى أجل غير مسمى، في المواقع التي بلغتها ضمن المنطقة العازلة وجبل الشيخ، متجاوزة كل الدعوات العربية والإقليمية والدولية للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974، كما أن إسرائيل مصرة على إبقاء جنوبي سوريا منزوع السلاح، وخالياً من التهديدات، وفق روايتها.
إسرائيل متحفزة بعد رحيل الأسد
وتشهر إسرائيل أيضاً “كرت الأقليات” كوسيلة لخلط الأوراق وتعقيد المشهد في سوريا، من خلال إطلاق تصريحات تقول فيها إنها معنية بحماية الأقليات، فإلى جانب انتقادها للعمليات العسكرية السورية ضد فلول النظام في الساحل، بدعوى أنها استهدفت مدنيين علويين، تتذرع بحماية الموحدين الدروز والدفاع عنهم، وتفتح الباب لاستقطاب عمال دروز للعمل في الجولان السوري المحتل، وذلك بعد زيارة وفد من رجال الدين الموحدين الدروز من قرى جبل الشيخ إلى الأراضي المحتلة.
وترافقت الزيارة مع تصريحات للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، قال فيها إن الحكومة السورية “متطرفة بكل معنى الكلمة، ومطلوبة للعدالة الدولية، وأي تساهل مع هذا الأمر لا نقبل به كسوريين”.
الناشط السياسي المقيم في الجولان السوري المحتل، رفعت عماش، أوضح لتلفزيون سوريا، أن الموقف الشعبي في الجنوب السوري من هذه التوجهات الإسرائيلية ينسجم مع موقف السوريين ككل، والروح الوطنية قادرة على الوقوف في وجه التدخلات الإسرائيلية ومحاولات الاستيلاء على الجنوب.
عماش اعتبر أن الأصوات التي ترحب بالتدخل الإسرائيلي لا تعدو كونها شوائب متأثرة بمخاوف منها ما هو وهمي وما هو واقعي، في الوقت الذي تحاول إسرائيل تصوير نفسها كمخلّص للسوريين في السويداء، وهذه الفئات تعطي صورة وكأن الموحدين الدروز مؤيدين للتدخل الإسرائيلي.
الناشط السياسي أشار إلى أن حالة الضعف في سوريا وغياب القوة حالياً على مواجهة إسرائيل سيجعل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية مسألة ليست قريبة، مع الإشارة إلى الطموحات الإسرائيلية التوسعية في سوريا.
وبحسب عماش، فالكيان الإسرائيلي متحفز لبسط نفوذه في الأراضي المحاذية للجولان بعد سقوط “الكلب الحارس للحدود” (في إشارة إلى بشار الأسد)، ولهذا تركز إسرائيل على رفض الوجود العسكري السوري في الجنوب، وفق رأيه.
وإلى جانب أسطوانة الأمن والتخلص من التهديدات وحماية الأقليات، يبدو القلق الإسرائيلي واضحاً من دعم تركيا للحكومة السورية الجديدة، في الوقت الذي تعتبر به أنقرة أن إسرائيل تعمل على خلق بيئة غير مستقرة في سوريا تحت ذريعة أمنها القومي، لكن الغاية فرض هيمنة إقليمية.
وفي 6 آذار، انتقد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في سوريا، والتحركات العسكرية معتبراً أنها تشكل استفزازاً واضحاً، وأن استراتيجية إسرائيل إبقاء جيرانها ضعفاء مستمرة لكنها غير مقبولة.
الاحتماء بروسيا من تركيا
تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة للإبقاء على سوريا ضعيفة ولا مركزية، مع إمكانية احتفاظ روسيا بقواعدها العسكرية على الساحل السوري، لمواجهة نفوذ تركيا المتصاعد في سوريا، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة.
الباحث الإسرائيلي قي قسم الشرق الأوسط بجامعة “تل أبيب” هاي إيتان كوهين يانروجاك، قال لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية في 5 آذار، “على المستوى الرسمي، أصحبت إسرائيل وتركيا جارتين، ولهذا السبب تدرك إسرائيل ضرورة التدخل في حرب الوعي التركية”.
وبحسب رأيه، فإن تركيا معنية بقضيتين محوريتين في علاقتها مع إسرائيل، الأولى، النشاط الإسرائيلي حيال الدروز في جنوبي سوريا، بالإضافة إلى المنطقة العازلة الإسرائيلية بين الجولان ودمشق، باعتبارها منطقة حكم ذاتي مستقبلية للدروز، أما القضية الثانية فهي الجانب الشرقي من البحر المتوسط، مع التركيز على علاقات إسرائيل مع قبرص، وحركة الغاز وأنظمة الشحن.
وهنا على وجه التحديد يأتي التعاون بين إسرائيل وروسيا، إذ تحاول إسرائيل حالياً منع الروس من مغادرة سوريا، وبالتالي الحد من التغلغل التركي في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط.
الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، قال لتلفزيون سوريا، إن تركيا تتعامل مع التحركات الإسرائيلية في سوريا على أنها تهديد لفرص نجاح عملية التحول، وتهديد لاستقرار سوريا، ولمصالح تركيا التي تنشد استقراراً في سوريا موحدة.
كما أن الرئيس التركي بعد اندلاع حرب غزة تحدث بوضوح عن أن السياسة التوسعية الإسرائيلية تشكل تهديداً لتركيا، وترى أنقرة الاندفاعة الإسرائيلية في سوريا على أنها جزء من سياسة توسع إسرائيلي إقليمي لا تشكل فقط تهديد لسوريا أو تركيا، بل للأمن والاستقرار الإقليمي.
وتتجلى أهداف إسرائيل في سوريا بتقويض قدرة الدولة السورية الجديدة على النهوض، ومحاولة فرض منطقة خالية من السلاح جنوبي سوريا، فتحاول فرض واقع أمني جديد مع سوريا باحتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوغلات التي تحولت إلى روتين يومي للجيش الإسرائيلي في الداخل السوري.
كما تعمل على تدمير ما تبقى من أصول عسكرية للدولة السورية، مع إحداث شرخ كبير بين المكون الدرزي والدولة السورية الجديدة، لتفكيك النسيج الاجتماعي وتهديد وحدة الأراضي السورية.
إسرائيل تحاول أيضاً شيطنة الإدارة السورية الجديدة أمام المجتمع الدولي، لإضفاء مشروعية على تحركاتها العدوانية في سوريا، وتضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سبيل عدم الانفتاح على دمشق.
وبرأي الباحث، فلا يمكن توقع كيف سينتهي الوضع في ظل هذه الاندفاعة الإسرائيلية لكن من الواضح أن الرئيس السوري أحمد الشرع يولي أهمية لتجنب حالة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع بين إسرائيل وسوريا، فأولويات دمشق هي استقرار المرحلة الانتقالية وتعزيز ركائز السلطة والتفرغ لبناء الدولة، وليس خلق صراعات جديدة.
تلفزيون سوريا
——————————–
سوريا وتجاوز ثنائيّة الأكثريّة والأقليّة!/ حسن المصطفى
سوريا اليوم في حاجة لأن تتجاوز فكرة ثنائية: العربي والكردي، المسلم والمسيحي، السني والشيعي، وألّا تنظر إلى الدروز والعلويين كأقليات، بل على الدولة الوطنية أن تكون حاضنة للجميع.
17-03-2025
لا يزالُ مفهوم “المواطنة” ملتبساً في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية، كون هذه المجتمعات لا تزال في حالة هجينة، لم تنتقل فيها تماماً إلى الدولة الوطنية الحديثة الناجزة، رغم أن عدداً منها مرت عليه عقود طويلة على الاستقلال، وجزء رئيس من هذا الخلل يعود إلى المنظومة المعرفية الهشة التي شُيدت عليها الأنظمة أو السياسات.
ثمة مفاهيم فلسفية أساسية تدخل في حقل “الفلسفة السياسية”، وهي بمثابة القاعدة الصلبة التي تشيد عليها مؤسسات الدولة، وتوزع وتفصل من خلالها السلطات، وتنتظم العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وأيضاً تُشكل الإطار المفاهيمي للدستور.
“المواطنة الشاملة” هي واحدة من أهم تلك المفاهيم، وهي إذ تحضرُ اليوم في الفضاء العربي – الإسلامي، فهي لا تُطل بوصفها قيمة ترفية، بل ركن ركين من دونه لا يمكن لمدماك الدولة الوطنية أن يستقر.
من تابع الأحداث الدموية والمواجهات العسكرية وعمليات التمرد والقتل والانتقام التي جرت في الساحل السوري، أخيراً، وراح ضحيتها أبرياء ومدنيون كثر – من دون الدخول في الجدل السياسي والغرق في وحول الإشاعات والمعلومات المضللة التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي – سيجد أن ما جرى يشير إلى قصور في فهم معنى “المواطنة” وإدراك كنهِها لدى شريحة واسعة من السياسيين والجمهور العام!
“المواطنة الشاملة” تعني في أبسط صورها أن الأفراد والجماعات في أي دولة، هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وأنه لا يجوز التمييز بينهم لأسباب عرقية أو دينية أو مناطقية، وهم بذلك لهم الحق في الحصول على فرصٍ متساوية، سواء في التعليم أم في العمل أم في الطبابة وسواها، وأيضاً يستطيعون التعبير عن ذواتهم الخاصة أو الجمعية، بشكل حرٍ ومن دون إكراهات.
هذا يقودنا بالتالي إلى أمرٍ يتجاوز المفهوم السائد لـ”الحقوق”، والقائم على تصورٍ منقوصٍ لـ”الديموقراطية” التي يتصور البعض أنها تعني حكم الأكثرية، وبالتالي يحق لهذه الأكثرية أن تضع ما تشاء من قوانين طالما كان ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها، وبقوة تصويت الأغلبية وتأييدها!
هذه النزعة فيها شيء من الاستعلاء وأيضاً يشوب ممارستها خللٌ كبير، لأنها سوف تنتهك مفهوم “المواطنة الشاملة” الذي يتجاوز التقسيمات القديمة: أكثرية وأقلية.
هذا التقسيم، يخلق تقابلاً يدفع نحو الصراع، وهو يتجاوز المنافسة السياسية إلى المناكفة وفرض ثقافة أعلى على أخرى أدنى!
وعليه، من الممكن أن يقود تقابلُ “الأكثرية” و”الأقلية” إلى تعميق القلق الاجتماعي وزرع بذور الريبة والشك المتبادل.
إن المجتمعات الحديثة في أوروبا على سبيل المثال، بنيت على مفهوم “المواطنة الشاملة”، وبالتالي تم تجاوز الثنائيات المتصارعة، لأن الجميع مواطنون، لهم هوياتهم الفرعية الخاصة، ولهم الحق في إبراز ثقافاتهم ومعتقداتهم، إنما ليس هنالك حق لأكثرية أن تضطهد أكثرية، ولا يمكن للأقلية أيضاً أن تتمرد على الأغلبية، لأن “المواطنة” تجعل المكونات المتجاورة محكومة بـ”القانون العادل” وتحت سقف الدولة المدنية.
سوريا اليوم بحاجة لأن تتجاوز فكرة ثنائية: العربي والكردي، المسلم والمسيحي، السني والشيعي، وأن لا تنظر إلى الدروز والعلويين كأقليات، بل على الدولة الوطنية أن تكون حاضنة للجميع، قادرة على تقديم خطاب وطني ترى فيه كل هذه المكونات ذاتها من دون انتقاص أو تضخم، ويفتح الطريق أمام بناء الدولة الحديثة وتنميتها.
هنالك واقعٌ صعب ومعقد في مجتمع عانى من حكم استبدادي طوال عقود خلت، وهو لا يزال لم يتداو من جراح الأحداث الدامية ما بعد عام 2011 وما جرته من مجازر وحروب أهلية؛ إلا أن هذا الإرث الثقيل من الوجع والعذابات يجب أن يكون حافزاً لبناء “مواطنة حقيقية” لا صورية، وأن يدرك الجميع أن الدم والثأر والكراهية والانتقام، كل هذه هي وصفات جاهزة للخراب الذي سيكون الجميع فيه خاسرون.
هذا الوعي المفاهيمي لا يمكن أن يحصل بين عشية وضحاها، بل لا بد من أن تبادر الدولة السورية والمجتمع المدني والقيادات الروحية والسياسية والمثقفين إلى بثِ روح وطنية واعية، تتسامى على الجراح، وتتجاوز الثنائيات المتجادلة والمتصادمة، وتذهب إلى مشاركة حقيقية في بناء الدولة وفق مشاريع عملية طموحة؛ و”المواطنة الشاملة” هي مفتاح رئيس لهذا التحول الذي ينشده السوريون وتتمناه لهم الدول والشعوب الصديقة.
النهار العربي
——————————-
هل تندلع الحرب بين أنقرة وتل أبيب على الساحة السورية؟!/ صالحة علام
20/3/2025
في تصعيد جديد ضد حكومة نتنياهو، صرّح الرئيس أردوغان بأن: “هناك قوى -لم يسمها- تحاول زعزعة الأمن والاستقرار داخل سوريا انطلاقا من إثارة النعرات الدينية والعرقية”، مؤكدا أن بلاده “لن تسمح بتقسيم المنطقة أو إعادة رسم حدوها بأطماع توسعية كما فعلوا قبل قرن من الزمان”، وأنهم سيجدون تركيا في مواجهتهم هذه المرة.
تصريحات أردوغان الجديدة جاءت ردا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة درعا، ومنطقة خان أرنبة في الجنوب السوري بالتزامن مع عودة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.
الموقف التركي من التحركات الإسرائيلية في المنطقة، التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية يبرز بقوة حجم المخاوف التركية من الأطماع التوسعية لدولة الاحتلال الصهيوني، والرغبة الجامحة لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق حلم نبوءة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
إذ سبق وأن حذر أردوغان من رغبة حكومة نتنياهو التي تقودها عقلية دينية متعصبة في التوسع جغرافيا على حساب الخريطة التاريخية لبلاده، والاستيلاء على مناطق الأناضول، تحقيقا لوهم الأرض الموعودة، والعمل على إقامة كيانات تابعة لها في كل من شمال العراق وسوريا عبر استغلال علاقاتها بالتنظيمات الانفصالية، في إشارة لعدد من الأقليات السورية الطامحة في الحكم الذاتي، ولقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لديها علاقات ممتدة بتل أبيب.
وكانت العديد من التقارير المتداولة إعلاميا قد أفادت أن توقيع قادة قوات سوريا الديمقراطية على اتفاق الاندماج داخل الإدارة الجديدة مع دمشق لم يقف حائلا دون استمرارهم في السعي لتأمين دعم إسرائيلي لهم في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة لهم، التي يحتاجون فيها -وفق رؤيتهم للتطورات بالمنطقة- لتوفير حلفاء وضامنين جدد لديهم القدرة على حمايتهم والوقوف إلى جوارهم.
وهو ما وافق هوى إسرائيل التي لا تنظر بارتياح لهذا الاتفاق، وترى أن تراجع الأكراد للخلف سيفسح المجال أمام عودة (داعش)، مما يضعها في موقف دفاعي صعب، إلى جانب شكوكها القوية وعدم ثقتها في الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي تمتد جذور انتماءاته إلى تنظيم القاعدة والجماعات الإسلامية الجهادية، مما قد يعرض أمنها للخطر، ويهدد وجودها.
ترى إسرائيل أيضا أن الجيش السوري الجديد الذي أُعيد بناء عناصره وتدريبهم بإشراف كامل من قيادات القوات المسلحة التركية، وتم تزويده بترسانة من الأسلحة المحلية المنتجة داخل هيئة الصناعات الدفاعية التركية أصبح يمثل خطرا من نوع آخر عليها، في ظل اتساع حجم النفوذ التركي داخل سوريا.
الذي يأتي متزامنا مع زيادة حدة التوترات وتفاقم خلافاتها مع أنقرة، على خلفية حربها ضد كل من قطاع غزة ولبنان، واختلاف أجندة كل منهما فيما يخص مستقبل الدولة السورية، إذ تعتقد إسرائيل أن تقسيم سوريا، وخلق كيانات متعددة بها من شأنه أن يضمن لها أمنها، ويمنحها الفرصة كاملة لتحقيق رغبتها في توسيع مساحتها.
ومن هذا المنطلق تدعم مطالب الحكم الذاتي لكل من الأكراد، والدروز، والعلويين، وتبذل جهودا مضاعفة حاليا من أجل دعم الطائفة الدرزية، حيث تم مؤخرا إرسال 10 آلاف طرد من المساعدات الإنسانية لأفرادها، وصرح جدعون ساعر وزير خارجية الكيان الإسرائيلي أن علاقاتهم بالدروز تاريخية، وأن عليهم الوقوف إلى جانبهم، لأنه “في منطقة نكون فيها أقلية، فمن الصواب دعم الأقليات الأخرى”.
أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس فصرّح أن حكومته قررت السماح للدروز من الجانب الآخر من الخط الفاصل بدخول هضبة الجولان والعمل بها، معربا عن استعدادهم للدفاع عنهم والوقوف إلى جوارهم دائما، بينما أعلن مسؤولون إسرائيليون أنهم لن يقبلوا وجود أي عسكري سوري في المناطق الجنوبية للعاصمة دمشق، وأنهم على أتم استعداد لغزو ضواحيها دفاعا عن الأقلية الدرزية المنقسمة بين إسرائيل وسوريا.
إلى جانب التصدي لمحاولات تركيا وأردوغان الرامية إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، واستعادة سيطرة بلاده على خريطة المنطقة كما كان عليه الحال في عهد الدولة العثمانية، وفي تقديم نفسها الوجود كقوة إقليمية فاعلة ذات نفوذ، لديها القدرة على التحكم في مستقبل المنطقة وفرض سيطرتها على مقدرات شعوبها، وهو ما يطلق عليه نتنياهو اسم “الشرق الأوسط الجديد”.
التحركات الإسرائيلية الداعمة للمطالب الانفصالية للأقليات السورية، والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد الأراضي السورية تنظر إليها أنقرة بريبة وشك، وتضعها في موقف الاستعداد لمواجهة تطورات الأمر بالسبل الممكنة كافة، حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية المباشرة.
لما تمثله هذه التحركات من تهديد مباشر لأمنها القومي، ومحاولة من جانب الكيان المحتل لتقويض مكانتها الإقليمية، وزعزعة استقرارها، والنيل من وحدة أراضيها عبر تشجيع الدعوات الانفصالية، ومساندة ودعم العناصر المسلحة التي تنتمي للتنظيمات الإرهابية لتخريب السلم الاجتماعي بالمنطقة.
وخلافا للرؤية الإسرائيلية التي تشجع على تقسيم سوريا وتعمل عليها، ترى تركيا أن وحدة الأراضي السورية، وإقامة دولة مركزية قوية ومستقرة بها من شأنه ضمان إخراج التنظيمات الانفصالية المسلحة، وإبعادهم تماما عن مناطق تمركزهم، والتخلص من تهديداتهم، بما يفسح المجال أمام الحفاظ على استقرار المنطقة، وإشاعة السلام بين شعوبها وتحقيق أمن دولها القومي.
ولتحقيق هذه الأهداف مجتمعة سعت أنقرة إلى زيادة حجم تعاونها العسكري مع دمشق عبر الاستعداد للتوقيع على اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، كما تم تعيين ملحق عسكري في السفارة التركية بدمشق، بينما قام مؤخرا وفد يضم كلًا من وزيري الخارجية والدفاع، ورئيس الاستخبارات بلقاء المسؤولين السوريين في دمشق، حيث تم تأكيد تمسك أنقرة بتسليم العناصر المسلحة لأسلحتها، وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، إلى جانب التباحث حول العديد من القضايا الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، التي من بينها بحث إقامة قاعدتين عسكريتين لتركيا في كل من دمشق وحمص، واستمرار عمليات تدريب الجيش السوري وتسليحه.
وهي التحركات العسكرية التي تراها إسرائيل تمثل تهديدا لها سواء على صعيد الجيش السوري الذي قد يصبح وكيلا لتركيا في حرب مباشرة ضدها، أو على صعيد تركيا نفسها التي يتزايد وجودها العسكري على الأراضي السورية، ودعمها المطلق لحكومة الشرع المؤقتة، وتزايد تهديداتها والتصعيد المستمر في خطابها العدائي ضد إسرائيل سواء من الرئيس أردوغان أو كل من وزيري خارجيته ودفاعه.
ما يبدو أنه شجع الشرع على التخلي عن أسلوبه الذي اتسم باللين تجاه إسرائيل منذ وصوله إلى دمشق، ليستخدم أسلوبا أشد حدة في الخطاب الذي ألقاه مؤخرا في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بالقاهرة، حينما قال: “إن توسع العدوان الإسرائيلي ليس انتهاكا للسيادة السورية فحسب، بل هو تهديد مباشر للأمن والسلام في المنطقة بأسرها”.
تعزيز تركيا لقدراتها العسكرية وتطوير دفاعاتها الهجومية وصواريخها الباليستية، وتعاونها المطلق مع سوريا في المجال العسكري تحديدا، وتصعيد تصريحات مسؤوليها ضد تل أبيب ينبئ بأن هناك استعدادات تجري انتظارا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة التي قد تشهد اشتباكا مسلحا بينها وبين إسرائيل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق غير مباشر.
المصدر : الجزبرة مباشر
كاتبة وصحفية مصرية مقيمة في تركيا
حاصلة على الماجستير في الاقتصاد.عملت مراسلة للعديد من الصحف والإذاعات والفضائيات العربية من تركيا
———————————
سورية… فيدرالية الأمر الواقع!/ أحمد مولود الطيار
20 مارس 2025
يرى كثيرٌ من السوريين أنّ أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ”الجولاني”، هو “رجل المرحلة” والضمانة الوحيدة لعدم انزلاق سورية نحو المجهول، حتى إنّ بعضهم بات يردّد مقولةً مستعارة من النظام السابق مفادُها أنّه لا يوجد بديلٌ قادرٌ على إنقاذ البلاد.
غير أنّ هذا الطرح يواجه انتقاداتٍ جوهرية؛ إذ إنّ استمرار الشرع في السلطة قد يؤدّي إلى تفتيت سورية إلى دويلاتٍ وكياناتٍ طائفيةٍ وعرقيةٍ متجاورة، ممّا يجعلها عُرضةً لصراعاتٍ أهليةٍ متكرّرة قد تهدأ لفترةٍ ثم تشتعل مجدّدًا طالما بقي في موقع الحكم. يُضاف إلى ذلك أنّ الشرع نفسه، والجماعة التي كان يقودها (هيئة تحرير الشام)، يقفان حجر عثرةٍ أمام رفع العقوبات الأميركية المنصوص عليها في “قانون قيصر”.
منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر/ كانون الأوّل 2024، وتولّي أحمد الشرع رئاسة سورية، تمرّ البلاد بتحوّلات عميقة تعيد رسم خريطة النفوذ والسيطرة. ويبدو أنّ البلاد أصبحت مقسّمة فعليًّا بين قوى مختلفة، لكلٍّ منها تحالفاتها وحساباتها الخاصة، ممّا يثير تساؤلاتٍ حول ما إذا كان الشرع قد وافق ضمنيًّا على تقسيم سورية أم أنّه وجد نفسه مضطرًّا للتعامل مع واقع جديد مفروض عليه. ففي الجنوب، تبدو السويداء وكأنّها منطقة مستقلة بحكم الأمر الواقع، حيث لا يملك “الجيش العربي السوري” القدرة على دخولها أو فرض سيطرته عليها. يعود ذلك إلى عدّة عوامل، أبرزها التهديدات الإسرائيلية المباشرة، إذ أكّدت حكومة نتنياهو مرارًا أنّها لن تسمح بوجود أيّ قوةٍ عسكريةٍ تهدّد الدروز هناك. كما أنّ بعض القيادات الدرزية ومشايخ العقل لا يخفون وجود قنوات تواصل مع إسرائيل التي باتت تُعتبر بالنسبة لهم ضمانة لحماية مصالحهم وسط اضطرابات المشهد السوري. هذا التفاهم غير المعلن جعل السويداء عمليًّا خارج سيطرة دمشق، أشبه بمنطقةٍ ذات حكمٍ ذاتيٍّ غير رسمي.
في الشرق، وحيث تمتدّ منطقة الجزيرة السورية التي تشكّل 41% من مساحة سورية، فالوضع لا يقلّ تعقيدًا. فهذه المنطقة الغنيّة بالنفط والموارد الطبيعية بقيت خاضعةً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، رغم تغيّر القيادة في دمشق. وتشير المعطيات إلى أنّ الاتفاق بين الشرع و”قسد” أرسى نوعًا من التفاهم الهش، بحيث تحافظ الإدارة الذاتية الكردية على استقلاليتها مقابل تفاهماتٍ شكليةٍ تتعلّق بالسيادة مع الحكومة الجديدة. ولم تعد العلاقة بين واشنطن و”قسد” مجرّد تحالفٍ تكتيكي، حيث تستخدم الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية “عند الحاجة” كما يردّد البعض، بل تحوّلت إلى شراكةٍ استراتيجية، إذ ترى الولايات المتحدة في “قسد” شريكًا مهمًّا لضمان الاستقرار في المنطقة، بينما تعتمد القوات الكردية على الدعم الأميركي لتأمين استقلالية قرارها بعيدًا عن دمشق. في ظلّ هذا الوضع، لا يملك الشرع خيارًا سوى القبول بهذا الترتيب، ممّا يعني أنّ الجزيرة السورية أصبحت فعليًّا خارج السيطرة المركزية.
أمّا الساحل السوري، وإن بدا حاليًا ضمن النفوذ المركزي لدمشق، إلا أنّ مستقبله غير محسوم، خصوصًا بعد التطوّرات الأخيرة. فقد تآكلت شرعية النظام بين العلويين ولم تعد مضمونة، وهذا على افتراض أنّها كانت موجودة سابقًا، ما يفتح الباب أمام سيناريوهاتٍ مختلفة، من بينها تعزيز الحكم الذاتي أو البحث عن تحالفاتٍ جديدةٍ تضمن استقراره. وفي ظلّ هذا المشهد، يرى بعض المراقبين أنّ المناطق المتبقية تحت سيطرة الشرع باتت تشكّل ما يشبه “كانتونًا سنّيًّا”، حيث يسعى إلى موازنة علاقاته مع القوى الدولية والإقليمية لضمان بقائه. وهو يدرك أنّ الاعتراف الدولي بحكمه لن يتحقّق إلا إذا التزم بحدودٍ واضحة مع إسرائيل جنوبًا، وتجنّب أيّ مواجهة مع “قسد” شرقًا، وضمان مصالح تركيا شمالًا. وبهذا، تبدو حدود مناطق نفوذه مرسومةً بوضوح، من دون أن يكون قادرًا على توسيعها من دون الدخول في صدام مع القوى الفاعلة في الملف السوري.
وعلى الرغم من أنّ الشرع لا يصرّح علنًا بموافقته على تقسيم البلاد، فإنّ تحرّكاته وتفاهماته مع القوى الإقليمية والدولية تعكس قبوله ببقاء مناطق النفوذ الحالية طالما أنّها لا تهدّد سلطته في دمشق. فالسويداء تبقى خطًا أحمر بالنسبة لإسرائيل، والجزيرة محميّة أميركية بحكم الواقع، والشمال يخضع للتأثير التركي المباشر، بينما تحتفظ دمشق ومحيطها بسيطرة الشرع، مع تقديمه بعض التسهيلات الاقتصادية والسياسية لضمان اعترافٍ دولي ولو كان مشروطًا. وبذلك، يبدو أنّ أحمد الشرع قد اختار التعايش مع هذا الواقع بدلًا من خوض مواجهةٍ عسكرية مع القوى الكبرى والإقليمية التي ترسم حدود النفوذ في سورية. فالتقسيم غير المعلن بات أمرًا واقعًا، حيث تتقاسم البلاد قوى متعدّدة، فيما يحرص الشرع على تثبيت موقعه ضمن هذه الخريطة الجديدة، ولو كان ذلك على حساب وحدة سورية الكاملة.
وبعيدًا عن التدخّلات الدولية وصراع المصالح الإقليمية، يبقى الخطر الأكبر على وحدة سورية هو سياسات أحمد الشرع نفسه. فمنذ وصوله إلى السلطة، لم يقدّم مشروعًا وطنيًّا حقيقيًّا يهدف إلى إعادة توحيد البلاد، بل اعتمد على سياسة إدارة الأزمات عوضًا عن حلّها. وقد أدّى هذا الاستئثار بالحكم إلى عددٍ من المخاطر، أبرزها تعميق الانقسامات الطائفية والمناطقيّة، حيث بات لكلّ منطقة إدارتها الخاصة وعلاقاتها الخارجية المستقلة، ممّا يعزّز احتمالات التفتّت على المدى البعيد. بالإضافة إلى إقصاء القوى السياسية الأخرى، حيث لم يبادر الشرع إلى إشراك القوى الفاعلة في حوارٍ وطنيٍّ حقيقي، بل اكتفى بعقد تفاهماتٍ مع جهاتٍ خارجيةٍ للحفاظ على سلطته، ممّا أضعف إمكانية بناء دولةٍ مركزيةٍ متماسكة. كما استمرّ في ترسيخ حكم الفرد بدلًا من بناء مؤسساتٍ قويّة، ما يجعل البلاد أكثر هشاشةً أمام أيّ أزمةٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ مستقبلية.
في الوقت الحالي، يبدو أنّ السلطة في دمشق تعمل وفق معادلة “التكيّف مع الأمر الواقع” بدلًا من السعي إلى مشروعٍ وطنيٍّ يوحّد السوريين. ولكن يمكن للشرع تبنّي نهجٍ جديدٍ قائمٍ على حوارٍ وطنيٍّ شاملٍ وحقيقي يشمل جميع المكوّنات السورية، من الأكراد إلى الدروز إلى العرب السنّة والعلويين، إضافةً إلى إصلاحاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ حقيقيةٍ تعيد ثقة المواطنين بالدولة عوضًا من الرهانات على الدعم الخارجي. وذلك كفيلٌ بإطلاق إعادة إعمارٍ متوازنةٍ تشجّع اللاجئين والنازحين على العودة إلى مناطقهم، ممّا يعيد توزيع النفوذ الداخلي. ولكن نجاح هذا الحلّ يتطلّب إرادةً سياسيةً قوية، وهو ما لم يظهر حتى الآن لدى الأطراف المتحكّمة بالمشهد.
السيناريوهات القادمة التي تنتظر سورية كثيرةٌ ومفتوحةٌ على احتمالاتٍ شتّى، وأحد تلك السيناريوهات أن يبقى الوضع الحالي كما هو عليه من دون إعلانٍ رسميٍّ للتقسيم؛ حيث تحافظ دمشق على سيطرتها على بعض المناطق، بينما تستمرّ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد، ويبقى الشمال السوري خاضعًا للنفوذ التركي، والجنوب تحت تأثير إسرائيل بشكلٍ غير مباشر. وقد تحدث تحوّلاتٌ تدريجيةٌ، مثل توقيع اتفاقياتٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ بين مختلف الأطراف، ممّا يؤدّي إلى نوعٍ من “الكونفيدرالية غير الرسمية”. وفي ظلّ الوضع الحالي، قد يبدو هذا السيناريو الأكثر واقعيةً على المدى القريب؛ إذ لا تزال الأطراف المتصارعة غير قادرةٍ على فرض حلٍّ نهائي. أمّا على المدى البعيد، فقد تتّجه سورية نحو أحد السيناريوهين: الفيدرالية الموسّعة أو إعادة توحيد الدولة، وذلك بناءً على مدى قدرة القوى الداخلية على تجاوز الانقسامات، ومدى استعداد الدول الكبرى لدعم حلٍّ شامل. أمّا السيناريو الأسوأ فهو التفكّك الكامل، لكنّه يظلّ أقلّ احتمالًا حاليًّا، لأنّ معظم الأطراف الإقليمية والدولية ترفض تقسيم سورية رسميًّا.
العربي الجديد
————————
من الانتقال السياسي إلى إعادة الإعمار.. معهد ألماني يقيّم سيناريوهات سوريا
ربى خدام الجامع
2025.03.19
قدم معهد الشؤون الدولية والأمنية الألماني* (Stiftung Wissenschaft und Politik)، تحليلاً معمقاً للوضع في سوريا بعد مرور أكثر من ستين عاماً على الديكتاتورية وأكثر من 13 عاماً على بدء الحرب، مع التركيز على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكام الجدد للبلاد.
ويشير التقرير إلى أن سوريا تقف على مفترق طرق حاسم يتطلب معالجة قضايا معقدة تشمل الانتقال السياسي، والمصالحة الاجتماعية، وإعادة الإعمار الشاملة، والتحول الاقتصادي، وعودة اللاجئين والنازحين، بالإضافة إلى حل قضايا أمنية شائكة مثل نزع سلاح الفصائل ودمجها ومحاربة تنظيم الدولة والجماعات المسلحة الأخرى.
تحديات الحكم والسيطرة الإقليمية:
يُسلط التقرير الضوء على أن الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد الشرع لا تسيطر على كامل الأراضي السورية، حيث لا تزال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الغالبية الكردية تسيطر على شمال شرقي سوريا، بينما تواصل تركيا سيطرتها على مناطق عدة في الشمال. وفي الجنوب الغربي، تحتل إسرائيل المنطقة العازلة وهضبة الجولان وجبل الشيخ، وتقيم نقاط تفتيش في المناطق المحيطة. ويستمر التقرير في بيان أن الاشتباكات المسلحة ما تزال دائرة في الشمال والشمال الشرقي بين الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً وقسد المتحالفة مع واشنطن.
يذكر المعهد أن الحكومة المؤقتة اتخذت خطوات لتسريح معظم جيش النظام المخلوع ومحاولة حل الفصائل ودمجهم في الجيش السوري الجديد، بما في ذلك قسد وفاصائل درزية. ومع ذلك، شهدت سوريا أعمال عنف طائفية عقب تمرد فلول للأسد، مما أسفر عن مقتل المئات وأكد على وجود ما سماه “عقيدة طائفية” وعدم انضباط في القوى الأمنية الجديدة، وهو ما يهدد عملية المصالحة.
التقدم السياسي المتعثر:
يشير التقرير إلى أن الإدارة الجديدة مضت قدماً في عملية الانتقال السياسي بتنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقالياً وتأكيده على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة وطناً للجميع. وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي جمع نحو 900 سوري لوضع إطار للعملية الدستورية. وفي بداية آذار، شُكلت لجنة لصياغة دستور مؤقت، وفي 13 آذار، وقع الشرع على إعلان دستوري يمتد لخمس سنوات، يحدد الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع ويطرح مبادئ فصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة وحرية التعبير. ومع ذلك، أثار الإعلان الدستوري انتقادات من مختلف الطوائف بسبب عدم تعبيره عن التنوع العرقي والديني لسوريا والإبقاء على تسمية “الجمهورية العربية السورية” وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة واشتراط أن يكون الرئيس مسلماً. ويؤكد التقرير على أن تحقيق توازن بين توقعات التنوع ومواقف الجهات الفاعلة المختلفة يمثل تحدياً كبيراً.
يُوضح التقرير أن القيادة السورية الجديدة تسعى لإعادة تموضع سوريا على المستويين الإقليمي والعالمي بهدف كسر العزلة وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار والحصول على دعم لإعادة الإعمار. وقد تواصل الشرع مع دول الخليج والدول الغربية، وهنأ ترامب على عودته إلى البيت الأبيض، معبراً عن أمله في إحلال السلام واقترح مناقشات مبكرة مع واشنطن. وفي حين حافظ على مسافة بعيدة عن إيران، أكد على أهمية العلاقات الطيبة مع روسيا وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، مؤكداً على التزام دمشق باتفاقيات وقف إطلاق النار وعزمها على حل النزاعات سلمياً، مع توقع علاقات ودية مع تركيا بشكل خاص.
مصالح الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية:
يُفصل التقرير مصالح وأولويات وممارسات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وتأثيرها على عملية الانتقال في سوريا.
تركيا: تسعى إلى محاربة سوريا لإرهاب (حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة)، والحفاظ على تنوعها العرقي والديني وإشراك جميع الأطراف في الحكم، وترغب في لعب دور فاعل في بناء سوريا قوية وموحدة بما يخدم مصالحها. تركز على مصالحها الأمنية وعرضت دعم إصلاح القطاع الأمني، وتسعى للتعاون مع سوريا والأردن والعراق لمحاربة تنظيم الدولة. كما دعت تركيا مقاتلي الفصائل السورية المتحالفة معها في الشمال للانضمام إلى الجيش السوري الجديد بهدف نزع سلاح قسد أو دمج عناصرها في الجيش السوري. وقد خلق إعلان عبد الله أوجلان عن حل تنظيمه أفقاً لتسوية بين تركيا وقسد، وتسعى تركيا لتعزيز التقارب بين قسد والمجلس الوطني الكردي. كما ترغب تركيا في لعب دور بارز في إعادة إعمار سوريا.
دول الخليج (قطر والسعودية والإمارات): يُشير التقرير إلى أن قطر قد تلعب دوراً مهماً في السياسة السورية وكانت أول دولة تزور دمشق بعد سقوط الأسد وتعهدت بدعم إعادة الإعمار. أما السعودية، فيبدو أنها منفتحة على تحقيق انفراجة وترغب في منع سوريا من الاعتماد بشكل كبير على قطر وتركيا. بينما من المحتمل أن تبقى الإمارات على هامش التطورات بسبب معارضتها لهيئة تحرير الشام، لكنها قد تجدد علاقاتها مع دمشق إذا تبين عدم وجود أساس لمخاوفها.
روسيا: غيرت سياستها من دعم نظام الأسد إلى محاولة السيطرة على الأضرار واستعادة نفوذها لتأمين مصالحها، وعرضت التعاون مع القيادة الجديدة. وقد صنفت هيئة تحرير الشام سابقاً كتنظيم إرهابي ثم وصفتها بـ”المعارضة السورية المسلحة” ثم “السلطات الجديدة”. ومع ذلك، قد تواجه روسيا صعوبة في تطبيع العلاقات بسبب مطالب دمشق بتسليم الأسد وجبر الضرر. وقد تراجعت قدرة روسيا على رسم شكل عملية الانتقال، لكنها ما تزال تحتفظ ببعض النفوذ السياسي وتأمل في أن يعوض وجودها العسكري والسياسي المتضائل تعاظم النفوذ التركي. وقد دعت روسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن وحذرت من صعود الحركة الجهادية وشبهت قتل العلويين والمسيحيين بالإبادة في رواندا، مما يدل على استعدادها لاستغلال أي توتر لمصلحتها.
إسرائيل: يهمها أمنها القومي أكثر من العملية الانتقالية أو النظام السياسي الجديد، وتشعر بالقلق إزاء الخلفية المتطرفة للحكام الجدد وتعزز النفوذ التركي. وتضغط على الولايات المتحدة لضمان سلامة القواعد الروسية وتفضل بقاء سوريا دولة لامركزية ضعيفة. كما أعلنت عزمها على الاحتفاظ بوجودها العسكري في سوريا وسعت لتمتين علاقاتها مع الطائفة الدرزية والأكراد وهددت بالتدخل العسكري دعماً للدروز.
الولايات المتحدة: لم تتضح بعد سياسة إدارة ترامب الثانية تجاه سوريا، لكنها تركز على مصالحها الأمنية والجيوسياسية وضمان عدم تحول سوريا إلى “مصدر للإرهاب الدولي” وأمن إسرائيل. وقد أثر قرار تعليق المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتاً على المخيمات ومبادرات المجتمع المدني.
إيران: خسرت نفوذها المباشر وتسعى للتواصل مع الحكومة المؤقتة، لكن دمشق لم تبد اهتماماً كبيراً بإعادة العلاقات. ومن السيناريوهات المطروحة لاحتفاظ إيران بنفوذها استغلال التوترات الطائفية أو تمتين علاقاتها مع قسد أو إعادة تعريف دورها عبر “المقاومة” المناهضة لإسرائيل وظهور جماعة “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا”.
نتائج وخيارات سياسية مقترحة من المعهد الألماني:
يُشدد التقرير على أن لألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في استقرار سوريا ويجب عليهم اقتناص الفرصة والمساهمة في ذلك بتنسيق نهجهم ضمن إطار متعدد الأطراف والتعاون مع الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج. ويدعو إلى مراقبة ودعم تطبيق إعلان حل حزب العمال الكردستاني والاتفاق بين الحكومة المؤقتة وقسد. كما يرى ضرورة العمل على تجديد التزام إسرائيل والحكومة السورية الجديدة باتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974 وتسهيل التواصل بينهما.
ويؤكد التقرير على أهمية تمهيد السبيل لزيادة المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات الأوروبية خطوة أولى ضرورية لكنها غير كافية، ويجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الضغط على واشنطن لرفع العقوبات الأميركية أو إيجاد آليات بديلة لدعم التعافي. ويشدد على ضرورة بقاء العقوبات على كبار الشخصيات التابعة للنظام السابق وهيئة تحرير الشام حتى تلتزم بشروط واضحة مثل الابتعاد عن الحركة الجهادية ومنع العنف الطائفي والتحقيق في المجازر واحترام حقوق الإنسان.
كما يحذر التقرير من الدفع نحو إعادة سريعة للاجئين السوريين ويدعو إلى تمكينهم من المساهمة في إعادة الإعمار من الخارج. ويؤكد على مسؤولية الجيش السوري الجديد في محاربة تنظيم الدولة وضرورة معالجة مشكلة السجون والمخيمات، مع تشجيع الولايات المتحدة على مواصلة دعم جهود مكافحة التنظيم.
أخيراً، يدعو التقرير ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى دعم تشكيل حكومة جامعة وصياغة دستور دائم يعكس تنوع سوريا العرقي والديني لمنع إيران من استغلال التوترات الطائفية وتحقيق مصالحة اجتماعية وسياسية في البلاد.
في الآتي ترجمة تلفزيون سوريا الكاملة للتقرير:
بعد مرور أكثر من ستين عاماً على الديكتاتورية في سوريا وأكثر من 13 عاماً على بدء الحرب التي تدخلت فيها أطراف دولية، أصبح حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات كبيرة، تتمثل بالانتقال السياسي والمصالحة الاجتماعية وإعادة الإعمار الشاملة، والتحول الاقتصادي، وإعادة اللاجئين والنازحين، إلى جانب حل قضايا أمنية شائكة تشمل نزع سلاح الفصائل ومن ثم إدماجها ضمن الهيكلية المعدلة للجيش ومحاربة تنظيم الدولة في حال عودته إلى جانب محاربة المسلحين من الموالين للأسد. وهنالك قضية أخرى تتمثل بأسلوب التعامل مع كل من مقاتلي تنظيم الدولة (وأهاليهم) المحتجزين في مخيمات ومراكز احتجاز تديرها قسد، والمقاتلين الأجانب المنضوين تحت صفوف هيئة تحرير الشام ومن والاها من الفصائل.
والأصعب من ذلك هو أن الحكومة المؤقتة التي يترأسها أحمد الشرع لا تسيطر على كامل التراب السوري، لأن قسد ذات الغالبية الكردية ماتزال تمارس سيطرتها على شمال شرقي سوريا، في حين تواصل تركيا سيطرتها على مناطق عدة في الشمال السوري. وفي جنوب غربي البلد، احتلت إسرائيل المنطقة العازلة التي أقيمت في عام 1974 وكانت في السابق تخضع لسيطرة أممية، إلى جانب احتلالها لجبل الشيخ منذ كانون الأول لعام 2024، كما أنها أقامت نقاط تفتيش لها في المناطق المحيطة بتلك الأراضي. وفي تلك الأثناء، ماتزال الاشتباكات المسلحة دائرة في الشمال وشمال شرقي سوريا ما بين الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً وقسد المتحالفة مع واشنطن في حربها ضد تنظيم الدولة.
الخطوات الأولى للعملية الانتقالية
قامت الحكومة المؤقتة بإجراءات لتسريح معظم عناصر جيش النظام البائد وحل الفصائل ثم دمجهم في الجيش السوري الجديد، وتضم تلك الفصائل قسد والفصائل الدرزية التابعة لغرفة عمليات الجنوب التي وقعت دمشق معها اتفاقيات خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار عقب حدوث أعنف أحداث طائفية في سوريا منذ سقوط النظام. إذ بعد ظهور تمرد موال للأسد ضد قوات الأمن الجديدة، قتل أكثر من ثمانمئة سوري معظمهم من الطائفة العلوية، بعضهم في اشتباكات وبعضهم الآخر في عمليات القتل الانتقامية التي أعقبتها والتي نفذت بحق من قُبض عليهم من العساكر والمدنيين، وهذه التطورات أكدت وجود عقيدة طائفية سائدة، إلى جانب عدم الالتزام بالانضباط وعدم وجود هياكل قيادة واضحة ضمن القوى الأمنية الجديدة، ما يشكل خطراً حقيقياً يهدد عملية المصالحة بين الطوائف العرقية والدينية في سوريا. وحتى قبل موجة العنف الأخيرة، ظهرت تقارير حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان نفذتها قوات الأمن الجديدة بحق أفراد من نظام الأسد المخلوع، ومعظم تلك الانتهاكات نفذت كأعمال انتقامية بحق العلويين.
مضت الإدارة الجديدة بعملية الانتقال السياسي نحو الأمام، إذ في أواخر شهر كانون الثاني من عام 2025، وبعد أن تم تنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقالياً على يد من انتصروا من الثوار، شدد هذا الرجل على ضرورة أن تصبح سوريا الجديدة وطناً لكل مواطنيها تختفي فيه كل أعمال الانتقام، وأكد على أهمية تشكيل حكومة جامعة تكفل تمثيل الجميع في مطلع شهر آذار. وفي أواسط شهر شباط، شكل الشرع لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بينهم ممثلون عن “حكومة الإنقاذ” السابقة في إدلب وعضوان من المجتمع المدني، ثم انعقد هذا المؤتمر الذي لم تسبقه فترة إشعار مناسبة، خلال الفترة ما بين 24-25 من شباط في دمشق، وجمع نحو 900 سوري من أجل وضع إطار العمل الميداني تمهيداً للمضي قدماً بالعملية الدستورية. وفي بداية شهر آذار، شكلت لجنة لصياغة دستور مؤقت، لكن الأمور لم تخضع لمداولة كبيرة، إذ بحلول الثالث عشر من آذار، وقع الشرع على إعلان دستوري يمتد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وحددت تلك الوثيقة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وطرحت مبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة أمام القانون وحرية التعبير. بيد أن مسؤولية التشريع خلال الفترة الانتقالية، ستكون بيد البرلمان الذي سيجري تعيين أعضائه (على أن يعين الرئيس وبشكل مباشر ثلث أعضائه)، أما الرئيس فيتمتع بسلطات تنفيذية وبيده أمر الإعلان عن حالة الطوارئ. كما سيجري تشكيل لجنة من أجل العدالة الانتقالية، إلى جانب لجنة لصياغة دستور دائم للبلد، وسيجري تأجيل الانتخابات حتى عام 2030. وسرعان ما أثار الإعلان الدستوري انتقادات من الطوائف في سوريا، إذ على الرغم من طرحه لمبدأ حرية الدين والمعتقد، لم يعبر عن التنوع العرقي والديني لسوريا التي احتفظت باسمها السابق (الجمهورية العربية السورية)، إلى جانب تسمية العربية وحدها كلغة رسمية للبلد، والتأكيد على وجوب أن يكون الرئيس مسلماً، ولكن لا شك بأن خلق حالة توازن بين توقعات التعبير عن التنوع بين الأغلبية والأقليات، وناشطي المجتمع المدني والعديد من الجهات الأجنبية الداعمة والفصائل المتطرفة الموجودة ضمن قاعدة القيادة الانتقالية نفسها يعتبر أمراً محفوفاً بالمخاطر والتحديات إلى أبعد الحدود.
وفي الوقت ذاته، تحرص القيادة السورية الجديدة على إعادة تموضع سوريا بعد سقوط الأسد على المستويين الإقليمي والعالمي، والهدف من ذلك كسر العزلة التي فرضت على البلد لفترة طويلة، وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار، إذ تريد سوريا الجديدة أن تتجنب تلك النظرة التي تعتبرها تهديداً على المستوى الإقليمي أو الدولي، والأولوية الأساسية في هذا السياق الحصول على الدعم من أجل إعادة إعمار البلد، ولتحقيق هذه الغاية، لم يمد الشرع يده لدول الخليج العربية فحسب، وعلى رأسها السعودية، بل للدول الغربية أيضاً، إذ هنأ دونالد ترامب على عودته الأخيرة إلى البيت الأبيض، وأعرب عن أمله بأن يعمل الرئيس الأميركي على إحلال السلام، واقترح قيام مناقشات مبكرة مع الإدارة الجديدة بواشنطن. وفي الوقت الذي احتفظ الشرع بمسافة بعيداً عن إيران، أكد مصلحته في المحافظة على علاقات طيبة مع روسيا، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، وأكد على التزام دمشق باتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة في عام 1974 وعلى عزمها على حل النزاعات مع دول الجوار بطريقة سلمية، والجميع يتوقع قيام علاقات ودية وتقارب مع تركيا على وجه الخصوص.
مصالح الجهات الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في سوريا
إن مصالح الجهات الفاعلة إقليمياً ودولياً وأولوياتها وممارساتها هي التي ستهيئ الساحة أمام حكام سوريا الجدد في تعاملهم مع التحديات التي تكتنف العملية الانتقالية بسوريا، إذ عقب سقوط نظام الأسد، عمدت بعض تلك الجهات الفاعلة الخارجية إلى تغيير موقفها، في حين أوضحت أطراف أخرى، مثل الولايات المتحدة، موقفها تماماً. بيد أن هنالك شيئاً واضحاً يهمهم جميعاً بالمقام الأول، ألا وهو المصالح القومية إلى جانب مراعاة الاعتبارات السياسية والاقتصادية الداخلية، وهذا ما يؤكد احتمال ظهور تضارب قد يعيق الجهود الساعية لتحقيق الاستقرار في سوريا.
تركيا
تشير التصريحات الرسمية الصادرة عن تركيا إلى وجود ثلاثة أهداف لديها في سوريا، أولها ضرورة عدم دعم سوريا للإرهاب (والمقصود هنا حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة) وعدم تشكيلها لأي خطر يهدد جيرانها، إلى جانب احتفاظها بتنوعها العرقي والديني وضرورة تمثيل وإشراك كل تلك الأطراف في الحكم. أي أن أنقرة تعتبر عملية نشر الاستقرار التي تقوم بها الحكومة المؤقتة الموجودة في دمشق ضرورة، وترغب في لعب دور فاعل في بناء سوريا القوية والموحدة، وبما ينسجم مع المصالح التركية الأساسية، ولهذا تسعى تركيا للانخراط في مجالين مهمين على المدى القصير والمتوسط.
أولاً: تركز تركيا على مصالحها الأمنية، ولهذا عرضت فكرة دعم عملية إصلاح القطاع الأمني في سوريا، وبحسب ما ذكره وزير الدفاع التركي يشار غولار، فإن أنقرة على استعداد لمساعدة الحكومة الانتقالية في التدريب العسكري إن لزم الأمر. وفي مطلع شهر شباط، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الشرع في أنقرة لمناقشة التعاون الوثيق في مجالات عدة، أبرزها احتمال توقيع معاهدة دفاع بينهما. كما تسعى كل من تركيا وسوريا والأردن والعراق لمحاربة تنظيم الدولة معاً، إذ عقد أول اجتماع للتباحث في هذا الشأن بالأردن في التاسع من آذار، من دون أن يعلن عن أي خريطة ملموسة للطريق في هذا الاتجاه.
في تلك الأثناء، دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، جميع مقاتلي الفصائل السورية الموجودة في شمالي سوريا والمتحالفة مع تركيا، والتي تضم أكثر من 80 ألف مقاتل إلى الانضمام إلى الجيش السوري الجديد. وهذه الدعوة تتماشى مع الاستراتيجية الأوسع لأنقرة الساعية إلى نزع سلاح قسد الذي تترأسه وحدات حماية الشعب الكردية، أو العمل على إدماج العساكر الأفراد ضمن جيش البلد الذي يخضع لقيادة دمشق بشكل كامل. كما تهدف دعوته أيضاً إلى طرد أي عناصر تركية (وغير سورية) موجودة ضمن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب من سوريا، ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت تركيا خطوات عسكرية من خلال الجيش الوطني السوري، كما استعانت بدعمها الجوي لقطع خطوط الإمداد عن قسد والموجودة في محيط عين العرب كوباني بالشمال السوري، فأضعفت بذلك القدرات القتالية لدى تلك المجموعة.
وفي الوقت ذاته، تمارس تركيا ضغطاً دبلوماسياً على قسد وحزب العمال، إذ في أواخر شباط الماضي، أعلن عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال المسجون في تركيا، عن حل تنظيمه ونزع سلاحه بكل ثقة، ما دفع بحزب العمال إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار والتصديق على ما أعلنه أوجلان والمطالبة بإطلاق سراحه. وهذا ما جعل الجهات الفاعلة الكردية في العراق، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ترحب بمبادرة أوجلان، ومن جانبه، أوضح القائد الأعلى لقسد، مظلوم عبدي، بأن حل الحزب ورمي سلاحه لا يمكن تطبيقه على قسد، لكنه أعرب عن انفتاحه على أي حل سلمي في سوريا.
خلق إعلان أوجلان أفقاً لتحقيق تسوية ما بين تركيا وقسد، وإزاء ذلك ظهر بين ثنايا إصرار أنقرة على ضرورة أن تكون سوريا شاملة وجامعة لكل الطوائف العرقية والدينية احتمال تأويل ذلك كبادرة على التفاوض من أجل تشكيل هيئة تمثيلية جديدة للكرد، إذ بالفعل، سعت تركيا منذ أمد بعيد لتعزيز التقارب بين قسد والمجلس الوطني الكردي الذي دعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، وفي مكالمة هاتفية مع عبدي، أعلن مسعود برزاني زعيم هذا الحزب عن دعمه للاتفاق الحاصل مؤخراً بين دمشق وقسد، وأكد على أهمية وحدة الكرد، كما رحب المسؤولون الأتراك بهذه الاتفاقية بحذر، وأكدوا على ضرورة تطبيقها بشكل كامل، وفي هذه الأثناء تواصلت الغارات الجوية التركية على العراق وسوريا.
أما المجال المهم الثاني الذي ترغب القيادة التركية في لعب دور بارز من خلاله فهو إعادة إعمار سوريا، إذ بعيداً عن الفرص الاقتصادية التي يرجح لشركات البناء التركية أن تقتنصها، يمكن لذلك أن يعزز شعبية أردوغان وسط حالة الضيق الاقتصادية التي تعيشها تركيا، كما أن أنقرة تعتبر إعادة إعمار سوريا شرطاً مهماً لتسهيل عودة اللاجئين السوريين.
دول الخليج
إذا نجحت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها في تعزيز موقفها، فإن قطر ستلعب دوراً مهماً في السياسة السورية هي أيضاً، إذ ليست مصادفة تلك التي جعلت من الأمير تميم بن حمد أول قائد دولة يزور دمشق بعد سقوط الأسد. ومنذ ذلك الحين، توالت زيارات المسؤولين والوفود القطرية على سوريا وذلك خلال شهري كانون الأول من عام 2024 وكانون الثاني عام 2025. وفي أواسط كانون الأول، كانت السفارة القطرية ثاني سفارة تعيد فتح أبوابها، بعد السفارة التركية، عقب تعليق العلاقات الدبلوماسية الذي نفذته دول كثيرة بين عامي 2011-2012 رداً على قمع النظام البائد للمعارضة. وتعهد رئيس وزراء قطر بدعم عملية إعادة إعمار سوريا وطالب بإنهاء العقوبات المفروضة عليها، إذ من الواضح تماماً بأن الدوحة قد وضعت نفسها في موضع أحد الوسطاء المهمين بين سوريا وأي دولة ثالثة، وستتعاظم أهمية هذا الدور في حال بقيت تلك الدول مترددة في التعامل مع الحكام الجدد لدمشق.
ثمة دولة أخرى بوسعها لعب دور مهم في المشهد الدبلوماسي السوري وهذه الدولة هي السعودية، إذ يبدو بأن هنالك مصلحة كبيرة لهيئة تحرير الشام في تعزيز علاقات طيبة مع أقوى دولة عربية، وقد ألمحت المملكة إلى انفتاحها على تحقيق انفراجة وذلك عندما أرسلت وزير خارجيتها الذي دعا على الفور إلى رفع العقوبات وقدم الدعم للحكومة الجديدة. ويبدو أن الرياض مستعدة للاعتراف بالواقع الجديد في دمشق مع التشجيع على الحوار والتعاون لإدارة النتائج المترتبة على سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة. وثمة شيء مهم لا بد أن تأخذه السعودية بالحسبان وهو منع سوريا من الاعتماد بشكل كبير على قطر وتركيا، غير أن قيام الشرع في مطلع شباط 2025 بأول زيارة خارجية له عقب سقوط الأسد إلى الرياض بدلاً من أنقرة يوحي باحتمال الابتعاد عن هذا الشكل من الاعتماد الكبير.
يحتمل للإمارات أن تبقى على هامش كل تلك التطورات نظراً لوقوفها ضد هيئة تحرير الشام ومعارضتها لها بشكل مبدئي وهذا ما يمنعها من التعامل معها مباشرة، لهذا يرجح لأبوظبي أن تراقب من كثب احتمال إثارة انتصار الإسلاميين في سوريا لمزيد من الاضطرابات في المنطقة، ولهذا لن تألو جهداً في منع وصول آثار ذلك إلى بلادها. ولكن إن تبين لها عدم وجود أصل أو أساس لمخاوفها، فإن الإمارات ستكون من بين تلك الدول التي ستحرص على تجديد علاقاتها مع دمشق.
روسيا
بما أنها كانت من أهم داعمي نظام الأسد في السابق، فقد غير الكرملين سياسته وانتقل إلى سياسة السيطرة على الأضرار مع سعيه في الوقت ذاته لاستعادة نفوذه السياسي من أجل تأمين مصالحه الأساسية في سوريا، وخاصة فيما يتصل بالاستعانة بالقواعد العسكرية الموجودة فيها، ولهذا عرضت روسيا التعاون مع القيادة الجديدة في دمشق لأنها ترغب أن تقدم نفسها كعنصر فاعل براغماتي على استعداد للتكيف مع ديناميات السلطة الجديدة. إذ حتى كانون الأول من عام 2024، بقيت موسكو تصنف هيئة تحرير الشام على أنها تنظيم إرهابي، ولكن في الثامن من كانون الأول 2024، أي في يوم سقوط الأسد، صارت تصف الهيئة بأنها “المعارضة السورية المسلحة” ثم أصبحت تصفها بـ”السلطات الجديدة”. وفي محاولة للتعامل مع الهيئة، أعلن فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة بأن التحالف الروسي مع سوريا “لا يرتبط بأي نظام”.
غير أن موسكو قد تكتشف صعوبة “تطبيع” العلاقات مع الحكومة التي تترأسها هيئة تحرير الشام، وهذا ما اتضح عندما زار نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سوريا في أواخر شهر كانون الثاني من عام 2025، إذ خلال تلك الزيارة، أوضح الشرع بأن على روسيا الاعتراف بما وصفه “أخطاءها السابقة” من أجل “إعادة بناء الثقة”، بيد أن هنالك مطلبين تقدمت بهما دمشق من المرجح أن يمثلا تهديداً حقيقياً لموسكو، خاصة في ظل ظروف الحرب المستمرة في أوكرانيا، وهذان المطلبان هما: تسليم الأسد وجبر الضرر، إذ لا أحد يتوقع أن تسلم روسيا الأسد على الإطلاق، بما أن تسليمه لا بد أن يقوض مصداقية روسيا بوصفها حامياً موثوقاً لحلفائها من المستبدين، أما فيما يتصل بالمطلب الثاني، فإن موسكو قد تعفي سوريا من قسم من ديونها الكبيرة المستحقة لروسيا، أو قد تعفيها منها كلها، أو قد تمدها بالحبوب أو النفط من دون أن تعترف رسمياً بما يُلزمها بتقديم تعويضات بهدف جبر الضرر. وفي تلك الأثناء، وفي محاولة منها لتحسين صورتها، قدمت روسيا اللجوء للسوريين الهاربين من العنف الطائفي الذي اندلع في آذار، وعرضت الاستعانة بقواعدها العسكرية كمراكز لوجستية لتوزيع المساعدات الإنسانية، ومن جانبها، ستبقى القوات المسلحة السورية معتمدة على روسيا في عمليات الصيانة وتأمين قطع التبديل في المستقبل المنظور.
لا شك أن قدرة روسيا على رسم شكل عملية الانتقال في سوريا قد تراجعت بشكل كبير، إذ لم يعد لدى روسيا حلفاء سياسيون أقوياء في سوريا، كما تراجعت إمكاناتها العسكرية على حماية هؤلاء الحلفاء، والأهم من كل ذلك أن عملية أستانا التي نسقت من خلالها روسيا وتركيا وإيران مواقعها تجاه مستقبل سوريا، لم يعد لديها أي نفوذ أو أهمية، ومع ذلك ما تزال موسكو تحتفظ ببعض النفوذ السياسي في سوريا، إذ يأمل الكرملين أن يتحول استمرار الوجود العسكري والسياسي على الرغم من تقلصه في سوريا نفسها وفي المنطقة كلها إلى مصلحة استراتيجية للحكومة الانتقالية، بما أن هذا الوجود سيقف ضد تعاظم الوجود والنفوذ التركي في سوريا. وبما أن روسيا تعتبر دولة قوية تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن وبما أنها عنصر فاعل مهم في المنتديات الدولية مثل دول البريكس+ والتجمعات الإقليمية مثل مجلس شنغهاي للتعاون، فإنه بوسع روسيا إما أن تسهم أو أن تعقد عملية تحقيق الاعتراف الدولي بالقيادة السورية الجديدة.
ونظراً لاحتمال التقارب بين روسيا والولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، ومطالبة إسرائيل بإبقاء القواعد الروسية في سوريا، والمجازر التي قامت ضد العلويين والمسيحيين في سوريا في آذار 2025، بات من الواضح أن الكرملين تعجبه الشروط التي تساعده على تعزيز موقفه ومكانة بلده، إذ إلى جانب الولايات المتحدة، دعت روسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن في منتصف شهر آذار حذر خلاله المندوب الروسي من صعود الحركة الجهادية في سوريا، وشبه قتل العلويين والمسيحيين بالإبادة التي حصلت في رواندا. ثم إن انعقاد الاجتماع خلف أبواب موصدة دليل على أن روسيا لا تريد أن تخاطر بعلاقتها التي ما تزال هشة مع القيادة الجديدة في سوريا، وفي الوقت عينه، يظهر ذلك استعداد روسيا الدائم لاستغلال أي توتر في سوريا لمصلحتها حتى تمارس الضغط عبر التلاعب ضمنياً بفكرة تأييد قيام حكم ذاتي في المنطقة الغربية من سوريا، بيد أن تصريح الشرع بأنه يرغب في الاحتفاظ بـ”علاقات استراتيجية عميقة” مع روسيا، وضرورة عدم وجود أي “شقاق بين سوريا وروسيا” يعتبر مؤشراً على نجاح سياسة الحد من الأضرار التي تنتهجها موسكو.
إسرائيل
في الوقت الذي تدعم المؤسسة السياسية الإسرائيلية عموماً “حق استقلال” الأقليات العرقية والدينية عن سوريا، ما يزال أشد ما يقلقها من جارتها هو أمنها القومي لا العملية الانتقالية ولا النظام السياسي الجديد فيها. إلا أن خلفية حكام دمشق الجدد تعتبر مصدراً للقلق بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة لتعاظم النفوذ التركي بما أن إسرائيل تعتبر تركيا عدوة، وبحسب تقارير ظهرت عبر الإعلام، فإن إسرائيل تضغط بشكل فاعل على الولايات المتحدة لضمان سلامة القواعد العسكرية الروسية الموجودة في سوريا، لأنها تفضل بقاء روسيا في وجه تركيا، كما تتمنى لسوريا أن تظل دولة لامركزية ضعيفة.
هذا ولم تكتف إسرائيل بالإعلان عن عزمها على الاحتفاظ بوجودها العسكري في سوريا في المستقبل المنظور، بل سعت أيضاً إلى تمتين علاقاتها مع الطائفة المقيمة في المنطقة الحدودية ومع الكرد أيضاً، إذ بنهاية شهر شباط عام 2025، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع كامل للمظاهر العسكرية من ثلاث محافظات سورية تقع في الجنوب، وهي القنيطرة ودرعا والسويداء، وأعلن أن إسرائيل لن تتسامح مع أي وجود للجيش السوري في تلك المناطق، وفي بداية شهر آذار، وفي ظل الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين قوات الأمن التابعين للحكام الجدد والفصائل الدرزية الموجودة في ضاحية جرمانا القريبة من دمشق، هددت إسرائيل بتدخل عسكري دعماً للطائفة الدرزية، وفي أواسط شهر شباط، سمحت لوفد مؤلف من شخصيات دينية درزية بزيارة مواقع دينية وزيارة الطائفة الدرزية المقيمة ضمن الأراضي التي تخضع لسيطرة إسرائيل وذلك لأول مرة منذ حرب عام 1973. كما عرضت إسرائيل على الدروز منحهم مساعدات وفتح فرص العمل أمامهم.
الولايات المتحدة
لم تتضح بعد ملامح المسار الذي ستسير عليه الولاية الثانية لترامب مستقبلاً فيما يخص سوريا، كما أن واشنطن لم تعتبر قيام مناقشات بشأن سوريا أولوية بالنسبة لها، ولكن السياسة الأميركية قد تتغير فجأة، وقد يؤثر ذلك بشكل خاص على الوجود العسكري الأميركي في سوريا وعلى التعاون الأميركي مع قسد، إذ تشير أولى الإرهاصات إلى أن إدارة ترامب لا تركز على “الانتقال الجامع” لأن ما يهمها هو مصالحها الأمنية والجيوسياسية، كما أن أهم أهدافها تتمثل بضمان عدم تحول سوريا إلى “مصدر للإرهاب الدولي” إلى جانب ضمان أمن إسرائيل.
وفي الوقت ذاته، ظهرت تعقيدات عقب القرار الذي أصدرته إدارة ترامب بخصوص تعليق كامل المساعدات الخارجية الأميركية بصورة مؤقتة، والتي تشمل تلك المساعدات التي تقدم للمرافق مثل مراكز الاحتجاز أو المخيمات وعلى رأسها مخيما الهول والروج حيث يحتجز مقاتلو تنظيم الدولة مع عوائلهم. وفي الوقت الذي تم التوصل فيه إلى حل مؤقت لتعويض العناصر الأمنية التي تحرس تلك المقرات، بما أن رواتبهم كانت في السابق تصلهم عبر التمويل المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإن اضطرابات حادة قد تعقب ذلك في حال قطع الحوالات إلى أجل غير مسمى. ولقد أضر تعليق المساعدات الخارجية الأميركية بعمليات المفوضية العليا للاجئين بشكل كبير في سوريا كما أضر بعدد من المبادرات الخاصة بالمجتمع المدني السوري.
إيران
مع سقوط نظام الأسد، خسرت إيران نفوذها المباشر في سوريا، وصارت تحرص اليوم على التواصل مباشرة مع الحكومة المؤقتة في دمشق، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن نهج إيران: “يقوم على سلوك الطرف الآخر”، ملمحاً إلى استعداد طهران لإحياء علاقاتها التي قطعها سقوط الأسد في حال سنحت لها الفرصة. بل حتى المرشد الأعلى، علي خامنئي، غير موقفه العدائي الذي أبداه في البداية تجاه الحكام الجدد لسوريا، فصار يركز الآن على المطالبة بـ”تحرير البلد من الاحتلال الأجنبي”، بيد أن دمشق لم تبد كبير اهتمام بإعادة العلاقات مع طهران، إذ حتى لو جرى إحياء تلك العلاقات، سيظل النفوذ الإيراني أضعف بكثير مما كان عليه من قبل، ونظراً لافتقار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الموارد الاقتصادية التي بوسعها تقديمها كحوافز مهمة، يرجح لدورها أن يبقى محدوداً في سوريا، أما جهود إعادة الإعمار فستقودها جهات فاعلة تتمتع بموارد مالية أكبر تحت تصرفها.
من السيناريوهات المنطقية المطروحة بالنسبة لاحتفاظ إيران بنفوذها ذلك السيناريو الذي يرى بأن ذلك يمكن أن يتم عبر استغلال أي توتر طائفي، إذ يرجح لطهران أن تزيد من تواصلها مع الطائفة العلوية في غربي سوريا، كما يمكن للتقارير التي تتحدث عن اعتقالات وإعدامات طالت العلويين على يد فصائل تابعة لهيئة تحرير الشام أن تغذي أنشطة خلايا المقاومة التي يمكن لإيران أن تدعمها بالسر كوسيلة لممارسة الضغط، بيد أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد وبشكل كبير على طريقة تعامل الحكام الجدد مع العدالة الانتقالية والديناميات الطائفية في سوريا.
وثمة نهج آخر مطروح وهو سعي إيران لتمتين علاقاتها مع قسد، إذ يمكن لتوقع الانسحاب الأميركي من سوريا أن يدفع قسد للبحث عن شراكات أخرى، وبحسب تقارير، فإن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني، أجرى محادثات مع قائد قسد، مظلوم عبدي، في مدينة السليمانية العراقية في مطلع كانون الثاني لعام 2025، وقد قيل إن بافل طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو من سهّل عقد ذلك الاجتماع. بيد أن عقد شراكة مع كرد سوريا لن يسمح لإيران بالاحتفاظ بنفوذها على الديناميات الداخلية لسوريا فحسب، بل بوسعه أيضاً الوقوف ضد النفوذ الإقليمي التركي مع كبح جماح العلاقات المتنامية بين إسرائيل والفصائل الكردية. غير أن الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين الحكومة التي تتزعمها هيئة تحرير الشام وقسد قد يتحول إلى مفتاح للعمل في هذا المضمار، إذ نظراً للشكوك المحيطة بتنفيذ الاتفاقية واحتمال تجدد التوتر بين القوات الكردية السورية من جهة ودمشق وأنقرة من جهة أخرى، يرجح لطهران أن تحافظ على فتح قنوات تواصل مع الكرد.
وأخيراً، قد تسعى طهران لإعادة تعريف دورها في سوريا عبر “المقاومة” المناهضة لإسرائيل، إذ بعد فترة قصيرة من الخطاب الذي ألقاه خامنئي في الثاني والعشرين من كانون الأول عام 2024، ظهرت جماعة لم تكن معروفة سابقاً، لكنها أطلقت على نفسها اليوم اسم: “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا”، وأعلنت أن هدفها هو طرد القوات الإسرائيلية من البلد، وهذا التطور قد يمد إيران بسبل جديدة للاحتفاظ بنفوذها في سوريا، إذ مثلاً، قد تعمد طهران إلى الاعتماد على قوات وكيلة جديدة أو إلى التحجج بـ”مقارعة الاحتلال” لتبرير تعاونها مع الحكومة السورية الجديدة.
نتائج وخيارات سياسية
لدى ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة في تأمين عملية نشر الاستقرار في سوريا وضمان عدم تشكيل هذا البلد لأي خطر على جيرانه وعلى أوروبا، لأن سقوط نظام الأسد قدم فرصة فريدة لتحقيق تلك الأهداف، إلا أن احتمال الخطأ ما يزال كبيراً، لأن النزاعات المسلحة قد تشتعل مرة أخرى في سوريا، وبدورها سوف تشجع العناصر الفاعلة الإقليمية والدولية على التدخل عسكرياً من جديد، وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن ذلك سيطيل أمد اقتصاد الحرب والاتجار بالمخدرات، وهذا ما سيدفع لظهور موجات نزوح جديدة، وفي الوقت ذاته، ستظل سوريا ملاذاً آمناً ومقراً لتجنيد العناصر ضمن تنظيم الدولة وغيره من الجماعات الجهادية.
ولهذا ينبغي على ألمانيا والاتحاد الأوروبي اقتناص هذه الفرصة التي ظهرت اليوم للمساهمة في نشر الاستقرار بسوريا، إلى جانب تنسيق نهجها بشكل وثيق ضمن عمل إطاري متعدد الأطراف، ويعتبر التعاون ضرورياً بشكل كبير مع الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ويجب أن ينصب الهدف على وقف تصعيد الخصوم الجيوسياسيين بدلاً من العمل على تأجيج هذا التصعيد، مع دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها على اعتبار ذلك أحد المبادئ الإرشادية ضمن هذا المضمار.
إن الإعلان عن حل حزب العمال الكردستاني من جهة، والاتفاق بين الحكومة السورية المؤقتة وقسد من جهة أخرى، يعتبر فرصة لحل التوتر في الشمال السوري، ولهذا لا بد من مراقبة تطبيق هذين الأمرين من كثب مع دعم العمليتين، وذلك لأن فشل أي منهما يمكن أن ينعكس بالسلب على الأخرى. وفي هذا السياق، من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف المشاركة فيهما، وعلى رأسها رغبة الكرد في الحصول على تمثيل يناسبهم في أي حكومة سورية مستقبلاً وكذلك رغبتهم في الحصول على حكم ذاتي بصلاحيات واسعة، إلى جانب مراعاة المخاوف الأمنية التركية ومصلحة دمشق في حل الفصائل وإنهاء السيطرة التركية على أجزاء من سوريا.
كما يجب على ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي العمل على ضمان تجديد التزام كل من إسرائيل والحكومة السورية الجديدة باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة عام 1974، وهذا من شأنه أن يجبر إسرائيل على سحب قواتها من المنطقة العازلة ومن جبل الشيخ وإعادة المنطقة لسيطرة قوات مراقبة فض الاشتباك الأممية. كما بوسع برلين وغيرها من شركائها الأوروبيين وبالتشاور مع الولايات المتحدة، تسهيل التواصل بين القيادة السورية وإسرائيل للحد من خطر المواجهات العسكرية، بما أن التواصل أضحى ضرورة نظراً لانتهاء العمل بآلية التنسيق الروسية الإسرائيلية لتجنب الصراع في سوريا.
ويجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي تمهيد السبيل أمام زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار سوريا التي دمرتها الحرب بعد سنين طويلة، وإن تحقيق تحسن سريع في الوضع الاقتصادي السوري يعتبر أمراً مهماً لنشر الاستقرار في البلد، إذ في أواخر شهر كانون الثاني، اتخذ مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خطوة في الاتجاه الصحيح عندما صدّق على خريطة طريق من أجل تخفيف العقوبات بشكل تدريجي على القطاعات والمؤسسات في سوريا. وبنهاية شهر شباط، جرى تعليق بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على قطاع الطاقة والنقل والقطاع المالي، على الرغم من أنها لم تُرفع بشكل كامل، إذ تعتبر تلك الإجراءات الأولية ضرورية لكنها ليست كافية، لأن العقوبات الأميركية ما تزال تمثل عائقاً رئيسياً أمام إعادة إعمار سوريا وتعافيها على المستوى الاقتصادي، ولذلك يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يضغطا على واشنطن حتى ترفع تلك العقوبات، وفي حال بقيت تراوح مكانها، عندئذ يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الخروج بآليات قابلة للتطبيق وذلك لدعم المساعدات الإنسانية ولتمهيد الطرق أمام التعافي الأولي للبلد، كما تجب إعادة توجيه الأصول المجمدة لنظام الأسد البائد نحو جهود إعادة الإعمار.
وفي الوقت ذاته، يجب أن تبقى العقوبات المفروضة على كبار الشخصيات التابعة لنظام الأسد وهيئة تحرير الشام، وقبل إخراج الهيئة من لوائح الإرهاب في ألمانيا والاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات عمن يمثلوها، لا بد لهم من تحقيق شروط واضحة، إذ يجب على حكام دمشق الجدد أن يظهروا ابتعادهم بشكل حقيقي عن الحركة الجهادية، وذلك عبر تعزيز العلاقات الخارجية بشكل سلمي مثلاً، أو عبر منع قيام عنف على أساس طائفي، وفتح تحقيق في المجازر التي ارتكبت في آذار 2025 ومحاكمة مرتكبيها، والالتزام بإقامة عدالة انتقالية شفافة، واحترام لحقوق الإنسان.
ومن جانبهما، يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يحجما عن الدفع نحو إعادة سريعة للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا حالياً، إذ لا يكفي الالتزام بمبدأ العودة الطوعية الآمنة والكريمة، بل أيضاً يجب أن يحل في سوريا ما يكفي من الاستقرار حتى تصبح جاهزة لعودة مواطنيها. ويجب على السياسة الأوروبية أن تولي الأولوية لتمكين اللاجئين على الإسهام بطريقة بناءة ودائمة في إعادة أعمار سوريا، بما أن هذه المساهمة يمكن أن تتم من الخارج. وفي الوقت عينه، ينبغي على ألمانيا دعم مفوضية اللاجئين في تسهيل عمليات العودة الطوعية، وهنا تظهر الحاجة لظهور حل وسط ما بين مصلحة ألمانيا في نشر الاستقرار بسوريا ومصلحتها في قدرتها على ترحيل الإرهابيين والمجرمين على وجه الخصوص، إلى جانب قدرتها على ترحيل السوريين الذين لا يندرجون ضمن هاتين الفئتين.
هذا ويجب على جيش سوريا الجديدة أن يتولى مسؤولية محاربة تنظيم الدولة، بما أنه التزم بذلك من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تركيا والعراق والأردن في مطلع شباط الماضي. أما مستقبلاً، فلا بد من مراعاة دور سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وفي تلك الأثناء، سيتعين على دمشق معالجة مشكلة السجون والمخيمات التي احتجز فيها مقاتلو التنظيم مع عوائلهم. ويجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي تشجيع الولايات المتحدة على مواصلة دعمها لمحاربة تنظيم الدولة وتمويل مقار الاحتجاز، وفي الوقت ذاته، يجب على الدول الأوروبية أن تحرص على إجلاء مقاتلي تنظيم الدولة الذين يحملون جنسيات أوروبية حتى تجري محاكمتهم في أوطانهم.
وأخيراً، يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي دعم تشكيل حكومة جامعة قائمة على المشاركة بشكل فاعل وصياغة دستور دائم لسوريا يعكس تنوعها العرقي والديني، لأن ذلك لا يعتبر ضرورياً فحسب من أجل نجاح العملية مستقبلاً، بل أيضاً لمنع إيران من استغلال أي توتر طائفي أو عرقي لمد نفوذها في سوريا، ولهذا السبب وغيره، يجب أن تكون الأولوية المركزية لأوروبا منصبة على الإسهام بإقامة مصالحة اجتماعية وسياسية في سوريا.
* Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) هو المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهو مركز أبحاث مستقل مقره في برلين، ألمانيا. يُعتبر من أبرز مراكز الأبحاث والاستشارات السياسية في أوروبا، ويُقدّم تحليلات ودراسات للحكومة الألمانية والبرلمان (البوندستاغ) حول القضايا الدولية والأمنية.
المصدر: Stiftung Wissenschaft und Politik
تلفزيون سوريا
——————————–
سوريا إلى أين؟/ بكر صدقي
تحديث 21 أذار 2025
من واكب التطورات السياسية في سوريا ما بعد نظام الأسد لا يخفى عليه تخبط المجموعة الحاكمة الجديدة أمام التحديات الهائلة التي خلّفها النظام المخلوع. بات وراءنا الآن أكثر من ثلاثة أشهر لم تسجل خلالها الإدارة الجديدة أي تقدم في أهم الملفات كالأمن والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي وتفكيك الفصائل المسلحة وتوحيد الجغرافيا السورية والمجتمع السوري.
لقد انبهرت هذه السلطة بسرعة توليها السلطة في اثني عشر يوماً، وبالقبول العربي والإقليمي والدولي الواسع والسريع بها، كما بقبول غالبية اجتماعية قام قبولها على الالتفاف حول الإنجاز الكبير المتمثل في إسقاط النظام. وفي حين تدين السلطة لسرعة إسقاط النظام بظرف إقليمي استثنائي هو ارتدادات عملية «طوفان الأقصى» وتداعياتها الكارثية، قام القبول العربي ـ الإقليمي ـ الدولي على رغبة الدول المعنية باستعادة الاستقرار الذي طال غيابه 14 عاماً وتسبب بتداعيات خطيرة وصلت آثارها إليها، كمشكلات الإرهاب وتدفق اللاجئين والمخدرات والأعباء الاقتصادية المرتبطة بها. أما القبول السوري العام فكان أساسه الفرح العارم بسقوط النظام وما عناه ذلك من انفتاح الأفق أمام تأسيس جديد يقطع مع الماضي الكارثي، إضافة إلى الأداء المقبول لهيئة تحرير الشام وحلفائها أثناء عملية «ردع العدوان» وبخاصة في مناطق حساسة كحلب ودمشق وجبال الساحل، حيث لم تشهد المعركة عمليات انتقامية واسعة النطاق أو أعمال عنف على أساس طائفي أو تضييقاً واسع النطاق على الحريات العامة والخاصة.
غير أن كل ذلك راح ينقلب إلى تراجع في شعبية الفريق الحاكم بمرور الأيام، بدءاً بمسرحية «مؤتمر الحوار الوطني» الهزلية وصولاً إلى المجازر الطائفية في الساحل مع الأسبوع الأول من شهر آذار الجاري، وأخيراً إصدار الإعلان الدستوري الذي لاقى انتقادات واسعة، فطغى على المشهد السياسي غياب الثقة بين قطاعات واسعة من المجتمع لا تقتصر على العلويين أو الأقليات، مقابل ارتفاع منسوب العدوانية اللفظية لدى مؤيدي السلطة الجديدة في مواجهة أي نقد لمسالكها حتى فيما اعترفت بها هي نفسها وشكلت «لجنة تقصي حقائق» بشأنها. مجمل القول هو أن الرصيد الكبير (المشروط) الذي حصلت عليه السلطة الجديدة في الداخل والخارج آخذ في التآكل كل يوم مع تراجع الآمال التي عقدت على التحول الكبير الذي تمت المراهنة عليه.
لن أدخل في تفاصيل نقد الإعلان الدستوري الذي قام به كثر وشمل مختلف مفرداته، ولكن من الطريف الإشارة إلى بند يتعلق برئاسة الجمهورية حيث ورد فيه شرط يتعلق بدين رئيس الجمهورية من غير أي إشارة إلى جنسيته، ربما لأن اللجنة الدستورية التي عينها الشرع لم تخطر ببالها هذه الثغرة الخطيرة حتى لو تعلقت باحتمال قريب من الصفر. فوفقاً لهذا الشرط يمكن لأي مسلم أن يشغل منصب رئاسة الجمهورية حتى لو كان غير سوري الجنسية، مع العلم أن هيئة تحرير الشام وفصائل جهادية أخرى فيها أعضاء أجانب من جنسيات مختلفة، وبينهم من تم تجنيسهم على عجل وبصورة غير معلنة!
لعل غموض أجندة الفريق الحاكم، وبخاصة قائده أحمد الشرع، في مسائل أساسية كشكل الدولة ونظام الحكم وغيرها، هو ما شجع كثيرين على المراهنة على تغيير لا بد أن يطال برنامجهما الأيديولوجي المعروف القائم على الفكر السلفي والنزعة الطائفية السنية. لكن هذا الغموض لم ينجلِ في الفترة المنصرمة إلا عن أسوأ الكوابيس التي استبعدها السوريون، فتفجر العنف الطائفي واتضحت الميول السلطوية والإقصائية من غير أن يظهر ضوء في نهاية النفق حتى لو كان طويلاً بحكم حجم المشكلات الهائل وضعف وسائل معالجتها.
وعلى رغم هذه المؤشرات المقلقة، يبقى أن السلطة ما زالت ضعيفة وهشة (وهذا بدوره مقلق) وخاضعة لاشتراطات كثيرة أغلبها للأسف خارجي، ستكون مرغمة على التعاطي الإيجابي معها لاستكمال شرعيتها المنقوصة، ولحل مشكلة العقوبات المفروضة على سوريا التي لا تسمح بإطلاق عجلة الاقتصاد، ولا يمكن للسلطة أن تحافظ على ما تبقى لها من شعبية قبل ذلك.
تطفو على السطح، في الحراك الاجتماعي السوري، مشكلة «المكوّنات» التي فشلت السلطة في إدماجها لأنها لم تر في السوريين إلا مكوّنات طائفية وعرقية وثقافية وسعت إلى التحايل عليها بدلاً من معالجتها بروح وطنية. بدا الاتفاق الذي وقعته السلطة مع قسد وكأنه «تاريخي» في أعقاب مأساة أهل الساحل، لكن الإعلان الدستوري بالصورة التي صدر بها قد أضعف من تاريخيته المحتملة، فلا رضيت عنه قسد ولا تيار وازن من دروز السويداء بقيادة الشيخ حكمت الهجري.
لا يمكن للمغمغة بشأن ديمقراطية الدولة وعلمانيتها، وهما شرطان لازمان لقيام دولة في سوريا تمثل جميع مواطنيها، أن تؤسس لهذه الدولة المأمولة، حتى لو تجنب أركان السلطة الكلمتين بذاتهما بحكم الإيديولوجيا التي تحكم تفكيرهم. ما لم تمض السلطة في هذا الاتجاه، ولو بخطوات بطيئة، نخشى سيناريوهات كارثية كتقسيم البلاد أو الحكم بالعنف المعمم مع شعبوية قاتلة. ويحتاج الفريق الحاكم إلى تحالف عريض مع فئات اجتماعية واسعة ليتمكن من تأسيس شرعيته. في حين أن الاستفراد بالسلطة والعجز عن تفكيك الجماعات المسلحة وتوحيد مناطق البلاد هو السائد إلى الآن. سوريا ليست بخير.
كاتب سوري
القدس العربي
——————————-
الأطماع التوسعية لإسرائيل في سوريا/ حنان البلخي
21/3/2025
تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري على قمة جبل الشيخ، التي تُعدّ واحدة من أهم النقاط الإستراتيجية في جنوب غرب سوريا. وتثير هذه التحركات غير المسبوقة تساؤلات حول النوايا الحقيقية لتل أبيب في المنطقة.
فعلى الرغم من تبريرها هذه الخطوات بدعوى “تعزيز الأمن”، فإن الواقع يشير إلى سياسة توسعية تهدف إلى فرض واقع جيوسياسي جديد.
لم تقتصر إسرائيل على إنشاء مواقع عسكرية إستراتيجية على قمة جبل الشيخ، تمنحها تفوقًا استخباراتيًا وعسكريًا على الحدود السورية- اللبنانية، بل أعلنت أيضًا رفضها وجود أي دفاعات قد تُهدد أمنها.
وقد تزامن هذا الإعلان مع خططها لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل الأراضي السورية بعمق 65 كيلومترًا في الجنوب. ورغم أن فكرة المنطقة منزوعة السلاح ليست جديدة، فإن استغلال إسرائيل الظروف التي تمرُّ بها سوريا في مرحلة التعافي، يثير الكثير من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية.
التحركات الإسرائيلية تتعارض مع مزاعمها بحماية الأمن والتصدي للتهديدات المحتملة، إذ يبدو أنها تستغل الفراغ الأمني في سوريا لتحقيق مكاسب إستراتيجية.
فمنذ سقوط نظام الأسد، شنّت إسرائيل ضربات على المعسكرات والمواقع العسكرية السورية، مستهدفة مصانع الأسلحة ومراكز إنتاجها؛ خوفًا من وقوعها في أيدي الثوار.
وعلى الرغم من تصريحات الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، التي أكد فيها أنه لا يسعى إلى أي مواجهة مع إسرائيل بل يعمل لتحقيق السلام، فلا تزال تل أبيب تدّعي أن تحركاتها العسكرية تأتي لدواعٍ أمنية.
تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي تحدث فيها عن “مراقبة” الرئيس السوري من قمة جبل الشيخ، تؤكد أن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ وجود عسكري دائم في المنطقة، وليس مجرد إجراءات أمنية مؤقتة.
لم تقتصر السياسة الإسرائيلية على تعزيز مواقعها العسكرية، بل امتدت إلى محاولات التدخل في الشؤون الداخلية السورية، خاصة من خلال التغلغل في صفوف الطائفة الدرزية، لا سيما في السويداء.
فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن إسرائيل تحاول استمالة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، عبر إغراءات مالية وسياسية بملايين الدولارات، بهدف تقويض وحدة الدولة السورية ودفع الدروز إلى الانفصال عن دمشق.
هذه التحركات تعكس إستراتيجية تل أبيب في استغلال مسألة “حماية الأقليات” لتعزيز نفوذها الإقليمي.
ظلّت جبهة الجولان هادئة لعقود تحت حكم الأسد، وهو ما فسّر الموقف الإسرائيلي الذي فضل بقاءه في السلطة، رغم امتلاكه أسلحة كيميائية استخدمها ضد المدنيين. ومع سقوط النظام، تبنّت إسرائيل نهجًا أكثر عدوانية، من خلال تكثيف هجماتها العسكرية في محاولة لإضعاف جهود إعادة بناء الدولة السورية.
تخشى إسرائيل من تصاعد الدور التركي في سوريا، وتخشى أيضًا من قيام حكومة سورية قوية متحالفة مع أنقرة. وهذا دفعها إلى تبني سياسة “فرق تسد” واللعب على وتر الطائفية لتعزيز الانقسامات الداخلية، خصوصًا بعد أحداث الساحل.
فقد عملت على نشر الفتنة الطائفية من خلال حملات تضليل إعلامي على منصات التواصل الاجتماعي. كما سعت إلى دعم قوات سوريا الديمقراطية في الشمال، من خلال الضغط لبقاء القواعد الأميركية في سوريا.
كما حاولت كسب دعم الدروز، مستغلةً الزعيم الروحي للدروز في الجولان المحتل، الشيخ موفق طريف. وقد فتحت الحدود أمام الدروز الراغبين في زيارة الأراضي المحتلة، وحرصت على تنظيم رحلات عبر حافلات إسرائيلية لنقلهم لزيارة مقام النبي شعيب. قبل ذلك، هددت إسرائيل بالتدخل لصالح الدروز في جرمانا.
لكن طموحات إسرائيل في تقسيم سوريا اصطدمت برغبة الشعب السوري في الحفاظ على وحدة وطنه، حيث رفضت الغالبية العظمى من السوريين من جميع الطوائف التدخل الإسرائيلي، كما اصطدمت هذه الطموحات بتحركات الحكومة السورية الجديدة.
وقد اتخذت الإدارة السورية الجديدة خطوات حاسمة لإفشال المخططات الإسرائيلية، من بينها توقيع اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” يقضي بدمج القوات الكردية في الجيش السوري وتسليم المؤسسات الرسمية وحقول النفط للدولة.
كما عملت دمشق على احتواء تمرد فلول النظام في الساحل، وملاحقة المتورطين في المجازر الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، بادرت الحكومة بفتح حوار مع وجهاء السويداء ونشطاء الطائفة الدرزية لتعزيز وحدة البلاد ومنع أي محاولات خارجية لاستغلال الخلافات الداخلية.
على الرغم من هذه الإجراءات، فلا تزال التحديات قائمة، ما يتطلب تضافر الجهود بين السوريين لدعم حكومتهم في مواجهة التهديدات الخارجية.
ومن الضروري أن تتحرك الإدارة السورية الجديدة بسرعة لحماية البلاد من أي تدخل إسرائيلي محتمل. ويُعدّ توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا، والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية في وسط وجنوب البلاد، خطوة إستراتيجية لتعزيز الموقف العسكري السوري، وتقليل خطر التدخل الإسرائيلي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
صحفية، وممثلة سابقة للائتلاف السوري المعارض في أوسلو
الجزيرة
———————————
——————————————-
=====================
===========================
الإعلان الدستوري لسوريا 2025-مقالات وتحليلات- تحديث 21 أذار 2025
تحديث 21 أذار 2025
——————————-
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
——————————–
الإعلان الدستوري السوري: بين الضرورة القانونية والانتقادات السياسية
نشر في 21 آذار/مارس ,2025
مقدمة
بعد إلغاء دستور 2012، في الإعلان الذي نصّ عليه بيان “مؤتمر النصر”، في 29 كانون الثاني/ يناير 2025، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في الثاني من آذار/ مارس 2025، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية تضم في عضويتها سبعة أعضاء، مهمّتها وضع مشروع لإعلان دستوري مؤقت للمرحلة الانتقالية في سورية، وقدّمت اللجنة مشروعها إلى الرئيس الشرع، وتم اعتماده والتوقيع عليه في 13 آذار/ مارس 2025، ليكون مرجعية دستورية مؤقتة للفترة الانتقالية التي حدّدها الإعلان بخمس سنوات.
ومن المتعارف عليه أن الدساتير توضع من قبل هيئة منتخبة أصولًا، إلا أنّ البلدان الخارجة من حروب داخلية، والتي يتعذّر إجراء انتخابات فيها، تلجأ إلى وضع إعلان دستوري مؤقت يُشكّل المرجع الرئيس لتنظيم المرحلة الانتقالية، ويقتصر الإعلان عادة على ما هو ضروري، ويتجنّب كلّ ما هو خلافي، حيث تُرجَأ القضايا الكبرى إلى مرحلة إعداد دستور دائم للبلاد بعد أن تتحقق عوامل الاستقرار. ويهدف الإعلان الدستوري عادة في البلدان الخارجة من حروب داخلية إلى خلق مناخ يُعزّز حالة الاستقرار والوضع الأمني وسبل تحقيق وحدة البلاد، كما يهدف إلى تعزيز أسباب المصالحة الوطنية واستعادة ثقة الشعب بالسلطة الجديدة والعهد الجديد، وخلق الثقة بين مكونات المجتمع، ومعالجة المشكلات الكبرى التي خلّفتها الحرب، وإلى تحقيق العدالة الانتقالية ونزع فتيل الانتقام، وإعادة بناء المؤسسات، والسير بسلام خلال المرحلة الانتقالية، تحضيرًا للمرحلة الدائمة وتهيئة الأجواء لوضع دستور دائم، وإجراء انتخابات تُنهي المرحلة الانتقالية، وتضع البلاد على سكّة السلامة والازدهار. والسؤال المتداول في هذا السياق: إلى أيّ حد حقق الإعلان الدستوري السوري هذه المتطلبات؟
أثار الإعلان الدستوري، كما هو متوقّع، وهو وثيقة مهمّة لمرحلة انتقالية ستحدد شكل سورية القادمة، جملةً من الردود المتباينة، منها المرحّبة والمؤيدة ومنها المنتقدة والرافضة، وجاءت هذه الردود من حقوقيين وأكاديميين وناشطين، ومن قوى سياسية ومنظمات حقوقية، وتتوزع المواقف على قوسٍ ينوس بين الترحيب والتأييد المطلق، والرفض الكلي، وما بينهما.
بدأت الانتقادات مع تشكيل لجنة صياغة مشروع الإعلان الدستوري، وهي لجنة تتألف من سبعة حقوقيين فقط، معظمهم يحملون التوجه الفكري والعقائدي ذاته، مع أن في سورية كفاءات مخلصة لثورة الشعب السوري تتمتع بقدرات وخبرات أوسع في هذا المجال، وافتقرت اللجنة إلى خبراء في السياسة والمجتمع والاقتصاد، علمًا أن مهمّة القانونيين عادة ما تكون تشكيل الصياغة القانونية للقرار السياسي وتوضيح المسار الرئيس لطبيعة المرحلة الانتقالية ومهامها، وتحديد الهيئات التي ستقود المرحلة الانتقالية ومداها الزمني. فليست اللجنة المختصة بصياغة الإعلان الدستوري هي من يحدد طبيعة النظام، أهو رئاسي أم برلماني أم مختلط، ولا هي من يحدد طبيعة النظام الاقتصادي وشكل الإدارة، مركزية أو لامركزية، ولا صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب وغير ذلك من المفاصل الرئيسية للمرحلة الانتقالية، إنما تحددها القيادة السياسية، وتلتزم لجنة الصياغة بها.
يُعدّ إصدار إعلان دستوري خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يُغني عن ضرورة معالجة القصور الذي يتضمنه خلال الفترة القادمة، المطلوب اليوم هو إجراء مقاربة متوازنة في التعامل مع هذا الإعلان، بعيدًا عن التمجيد المطلق أو الرفض القاطع، عبر مناقشته بموضوعية، وتعزيز جوانبه الإيجابية، والعمل على تصحيح نواقصه بما يخدم مصلحة السوريين. وبوجه عام، يمثل هذا الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه ليس نهاية المسار، بل بداية لمرحلة تتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف، لضمان نجاح الانتقال السياسي، وضمان أن يُعبّر أي دستور مستقبلي عن إرادة السوريين عبر لجنة تأسيسية منتخبة واستفتاء شعبي شفاف.
جدالات السوريين حول الإعلان الدستوري
على عكس الاهتمام الثانوي الذي منحه السوريون لإصدار دستور 2012، فقد لقي الإعلان الدستوري الحالي اهتمامًا واسعًا في أوساط السوريين وأوساط المتابعين غير السوريين للأحداث السورية، ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت التي تكاد تصل اليوم إلى كل إنسان، دورًا كبيرًا في زيادة هذا الاهتمام، وكانت ساحة الجدال الرئيسة. وبسبب سخونة الأجواء السورية، عقب سقوط النظام أواخر السنة الماضية، والتغييرات على المستويين الرسمي الحكومي والشعبي، والتغيرات في إيقاعات الحياة اليومية في الساحة السورية، جاءت ردّات فعل السوريين قوية على مجمل التحولات، بناءً على مواقف ذات خلفيات متباينة تتأرجح بين أيديولوجيا السلفية الجهادية والأيديولوجيا الليبرالية وما بينهما، ولكل منها رؤيتها لنظام الحكم القادم في سورية، أو بناءً على دوافع دينية ومذهبية ومناطقية، وتأثيرات أحداث الساحل وما جرى بها من أعمال، ومحاولات بعض ضباط النظام القيام ببعض الأعمال العدوانية ضد قوات الأمن، وردّ هذه القوات القوي عليها، ثم التداعيات التي تلتها من تجاوزات وانتهاكات، واصطفاف السوريين حولها بين مبرر ومتقبل واعتذاري وناقد، يضاف إلى ذلك وجود منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات قسد، ولها مطالب محددة تريد أن تراها في الدستور، ووجود منطقة السويداء، ولها هي الأخرى مطالب محددة، وظهور ردات الفعل والمواقف على إثر الشكل الذي جرى به ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني، أو تشكيل لجنة إعداد مشروع الإعلان الدستوري، وفوق كل ذلك تأثير الأوضاع المعيشية المتردية لمعظم السوريين، وعدم إحراز أي تحسّن ملموس في هذه الظروف خلال هذه المدة القصيرة، مع انعدام الإمكانيات ولا سيما مع الضغوط الأميركية على الجهات التي وعدت السلطات الجديدة بتقديم مساعدات، وغيرها.
ضمن هذه الأجواء، استقبل السوريون الإعلانَ الدستوري باهتمام واسع، كما ذكرنا، وقد تباينت المواقف مما جاء فيه بين مرحّب بقوة، ورافض بقوة، وما بينهما من مواقف اتسم بعضها بالتحليل والنقد الموضوعي من منطلق إيجابي. وقد غلب على غالبية المواقف الرغبة في أن تجتاز سورية المرحلة الانتقالية بنجاح، فقد تعب السوريون من الحروب، وهم يتطلعون للاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها وتحسّن شروط عيشهم وتوفّر فرص العمل وزيادة دخولهم التي تدهورت إلى حد الجوع. واتسم بعض تلك المواقف بالنقد الشديد، مثل موقف (قسد) و(مسد) إذ أعلنتا رفض الإعلان الدستوري بالكامل، ورأتا أنه يتجاهل التعددية القومية والدينية في سورية، وأنه يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، حيث يكرّس الحكم المركزي، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات كبيرة، ودعوا إلى إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية. وصدرت انتقادات واعتراضات من جهات أخرى مثل المنظمة الآثورية الديمقراطية، كما صدرت بعض الأصوات المعارضة له في السويداء على صعيد الفئات الشعبية ومشايخ العقل، واعتبروه بأنه لا يمثل التنوع السوري، كذلك انتقدته بعض المنظمات الحقوقية وبعض القانونيين، وعبرت بعض التيارات الليبرالية والعلمانية عن انتقاداتها بدءًا من تشكيل اللجنة الدستورية، التي لم تضمّ ممثلين عن جميع مكونات الشعب السوري لضمان صياغة إعلان دستوري يعبّر عن الجميع، وانتقادها الإعلان كونه لا يتبنى نهجًا ديمقراطيًا حقيقيًا، وأبقى على نصوص تميّز بين السوريين، بما يخرق مبادئ المواطنة المتساوية كأساس للحكم، ولا يضمن الإعلان حيادية الدولة.
الشعب مصدر السلطات:
غاب عن الإعلان الدستوري أيّ ذكر لمبدأ السيادة الشعبية، وهو ليس مجرد تعبير رمزي، بل يشكل جوهر الشرعية السياسية، إذ يمنح المواطنين القدرة على فرض إرادتهم، من خلال الاستفتاء الشعبي والآليات الديمقراطية الأخرى، ويثير هذا الغياب العديد من التساؤلات، لا سيما أن المادة 52 تنص على أن الإعلان يبقى نافذًا حتى إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات وفقًا له، من دون تحديد الجهة التي ستقر الدستور الدائم، وكيفية إقراره، مما يفتح الباب أمام فرض دستور دون الرجوع إلى إرادة الشعب، وكان من الضروري أن ينصّ الإعلان بوضوح على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن المرحلة الانتقالية ستُفضي إلى نظام تعددي قائم على التداول السلمي للسلطة.
النظام السياسي:
لم ينص الإعلان على أن نظام الحكم في الدولة السورية هو نظام جمهوري، إلا أن المادة 2 نصّت على إقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، وهي صيغة غامضة، في حين إنه نص من جهة أخرى على صلاحيات واسعة للرئيس، مما يضعف مبدأ الفصل بين السلطات. وقد كان اختيار النظام الرئاسي الموضوع الأكثر أهمية في الإعلان الدستوري المؤقت، فالبلدان التي تخرج من حروب داخلية تتجنب النظام الرئاسي، وتلجأ إلى النظام البرلماني الأوسع تمثيلًا، مثل ألمانيا بعد هتلر، إيطاليا بعد موسوليني، وإسبانيا بعد فرانكو، والبرتغال بعد سالازار وغيرها، ونجحت في اختيارها، بينما فشلت دول تبنت النظام الرئاسي عقب خروجها من حروب أهلية، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، إذ تحوّل النظام الرئاسي إلى استبداد عانت منه طويلًا. ومن ناحية أخرى، فإن سورية قد عانت استبداد النظام الرئاسي الأسدي لخمسة عقود، حيث سيطر الأسد على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة، إضافة إلى الجيش والأمن. ويعتقد خبراء آخرون أنه كان من الأجدى اتباع النظام البرلماني، ولا سيما أن الإعلان الدستوري قد وضع بيد الرئيس القدرة على التحكم في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى قيادة الجيش، من دون وضع أي قيود عليه وتحديد أي سلطة لها قدرة على محاسبته، مما يجعل مبدأ فصل السلطات الذي نصّ عليه الإعلان مجردَ حبر على ورق. في حين رأى أنصار النظام الرئاسي أنه الأنسب لسورية، حيث يمركز السلطات في يد رجل واحد، مما يساعد على اجتياز المرحلة الانتقالية بسلام. وكان من اللافت أن الإعلان قد أغفل وضع ضوابط لحالة تجاوز رئيس الدولة لمهامه أو مخالفته لمقتضيات منصبه، فضلًا عن عدم وجود آلية لعزله، في حال مخالفته للإعلان الدستوري، ولم يحدد الإعلان الشروط الواجب توفرها في من يتولى رئاسة الجمهورية، وقد كان من الضروري النص على شروط واضحة لتولي المنصب، مثل ضرورة تمتّع المرشح بالجنسية السورية بالولادة أو بالاكتساب، والحد الأدنى للعمر، ومدى جواز حمله لجنسية أخرى، ومستواه التعليمي، وغيرها من المتطلبات الأساسية ويبدو أنه افترض أن السيد أحمد الشرع هو الرئيس دون الحاجة إلى وضع معايير أخرى.
النظام الاقتصادي والعدالة الاجتماعية:
لقيت قضايا النظام الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وموضوعات توزيع الدخل بعض الاهتمام في الإعلان، فقد نصّت (المادة 16) على صيانة حقوق الملكية الخاصة، وعدّتالثروات الباطنية ملكية عامة تستثمرها الدولة لصالح المجتمع، ونصت (المادة 11) على أن الاقتصاد الوطني يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وأن الاقتصاد الوطني سيقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار، وأن الدولة تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة. ولم يكن هناك نصّ صريح على “اقتصاد السوق الحر”، وهو التعبير المحدد لاقتصاد السوق الذي يقوم على حرية الاستثمار والدخول إلى السوق والخروج منها وحرية تشكّل الأسعار وفق مبدأ المنافسة، ونصت (المادة 15) على أن العمل حق للمواطن، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. ولم ينص الإعلان على حماية العمل وحقوق العاملين، أسوة بما ذكره عن حماية المستثمرين.
يعدّ هذا الاهتمام أقلّ مما تستحقه موضوعات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الدخل، والتي تقوم عليها حياة الفرد والمجتمع. وكما هو معتاد، فإن اهتمامات الناس ومناقشاتهم الكثيرة حول الإعلان الدستوري المؤقت لا تأتي في معظمها على ذكر هذا الجانب رغم أهميته القصوى. ويأمل السوريون أن يروا ترجمة فعلية لسياسات تعزيز العدالة الاجتماعية، سواء في رسم السياسات العامة أو في ممارسة مؤسسات الدولة، مستفيدين من خبرة بلدان أخرى ترى أهمية في تقليص التفاوت الاجتماعي وتحسين عدالة توزيع الدخول بما لا يكبح تنمية الإنتاجية.
النظام الإداري:
لم يتطرق الإعلان بوضوح إلى طبيعة النظام الإداري، وهي تعدّ جزءًا من أسس بناء الدولة، ولا سيما أن سورية كانت خلال العهد المنصرم دولة شديدة المركزية، في مختلف جوانب الحياة، مما أعاق نمو الفرد والمجتمع من الناحيتين المادية والروحية، وهذه القضية هي موضع نقاش حار بين السوريين، سواء من جانب المنطلقات القومية، مثل مطالب الكرد السوريين الذين ينادون باللامركزية السياسية والفيدرالية، أو من جانب تقني إداري يدعو له خبراء في الإدارة ويقوم على لا مركزية إدارية واسعة تمنح السلطات المحلية المنتخبة والخاضعة للمحاسبة الكثير من صلاحيات إدارة شؤونهم المحلية، بما في ذلك تأمين موارد مالية كافية لهذه الإدارة المحلية. وقد طبّق النظام السابق نظام الإدارة المحلية منذ سبعينيات القرن المنصرم، ولكنها كانت ضعيفة وهامشية أمام سلطات المحافظ الذي يسميه رئيس الجمهورية، وسلطات الأمن التي قضمت صلاحيات جميع المؤسسات.
وقد تضمنت المادة 7 (الفقرة 3) نصًا يشمل الحقوق الثقافية للمكونات السورية، حيث “تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين”، إضافة إلى المادة 10 التي تحظر التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية المجتمعات ذات الروابط اللغوية والثقافية المتميزة. غير أن هذا النص يبقى أقل من مطالب الكرد الأخرى المتعلقة بتسمية سورية واللغة الكردية وموازنة مستقلة وغيرها من مطالب، وقد تم التوصل إلى اتفاق أبرمه كلٌّ من الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، أعلنت خطوطه العامة فقط وكان هذا بمثابة اختراق، ويتوقع وجود عقبات غير سهلة في وضعه قيد التنفيذ.
مصدر التشريع:
جعل الإعلان الدستوري الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، ويرى المؤيدون أن هذا حق طبيعي للسنّة الذين يشكلون أكثرية الشعب السوري، وأن الدساتير السورية طالما تضمنت هذا النص، وكانت سورية بخير قبل سلطة البعث، ويعتد المؤيدون للنص بأن دولًا متقدمة ديمقراطية في أوروبا وأمريكا (بولندا – السويد – آيسلندا – اليونان مالطا وبعض دول أمريكا اللاتينية) تنص دساتيرها على نوع من دين الدولة ودين الملك، وتحمل بعض أعلامها رموزًا دينية، ويرى المعارضون أن هذا صحيح، ولكن دساتير هذه الدول لا تنص على أن مصدر تشريعاتها هو من تراث الكنيسة وما جاء به الأولون، بل تشريعهم وضعي بالكامل، وتنص دساتيرهم على فصل الكنيسة عن الدولة وشؤون الناس اليومية، وتترك حرية العبادة وممارسة الطقوس، ولا يوجد فقه ديني مسيحي ليكون هو مصدرًا لتشريعاتهم، إضافة إلى وجود مجتمع قوي مدني وثقافة راسخة لا تسمح للكنيسة بالتدخل في الشؤون المدنية. ويرى المعارضون أيضًا أن هذا النص يدخل مستقبل سورية في متاهة، فالفقه، وعمره 1400 عام، يضم مذاهب متعددة واجتهادات فقهية بمئة اتجاه واتجاه، ثم هي مرتبطة بأزمنة وأمكنة متحولة عبر الزمن، وتختلف جذريًا عن طبيعة عصرنا الأكثر تعقيدًا من تلك العصور بمئات المرات. وأن الحاكم في الفقه الإسلامي (الخليفة، أمير المؤمنين، السلطان، والرئيس حديثًا) هو حاكم مطلق في كل الشؤون ولا يشاركه في السلطة أحد، يشاور من يريد دون إلزام بأخذ رأي أحد، ويحرم معارضة الحاكم والخروج عليه، وقد كان هذا في المجتمعات القديمة غربًا وشرقًا، ولكنه أصبح من مخلفات الماضي في المجتمعات الحديثة، خاصة أن هذا يتعارض مع النص في الإعلان الدستوري على الحريات العامة في التنظيم والتعبير والاعتقاد في المجتمعات الحديثة، والتي تتضمن حكمًا الحق بمعارضة الحاكم.
يرى خبراء أن المسألة ليست في النص بقدر ما هو السياق، فالنص ذاته كان موجودًا في دستور 1950 ودستور 1973 ودستور 2012، ومع ذلك لم تتقيد السلطات الحاكمة منذ 1950 بالفقه الإسلامي إلا في قانون الأحوال المدنية، وكانت تنهج نهجًا وضعيًا في صياغة التشريعات والقوانين الأخرى، عدا قوانين الأحوال الشخصية، ويتخوف المعارضون اليوم من أن القوى الممسكة بالسلطة هذه المرة ذات مرجعية سلفية جهادية في الأصل، وإن مالوا إلى اللين الآن، وثمة خوف وقلق من أن يباشروا بعد تمكنهم بفرض التشدد، وقد بدأت بعض الممارسات والدعوات المتشددة تبرز هنا وهناك، على نحو يختلف عما تعوده معظم السوريين، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، ويخشى البعض أن يزداد التشدد وتغيب المرونة الحالية التي يبديها هؤلاء العناصر. وبالتالي سيصبح هذا النص قيدًا يعتد به المتشددون على كافة التشريعات والقوانين، وقيدًا على الحياة المعاصرة. وقد اقترح أحد الخبراء في شؤون الدين والفقه، أن الأجدى، ضمن السياقات الحالية، النص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس للتشريع”.
دين الدولة ودين رئيس الدولة:
مسألة دين الدولة ورئيسها واحدة من النقاط ذات الحساسية، لاعتبارات واصطفافات مذهبية ودينية، وقد تجنب الإعلان النص على دين الدولة، ولكنه نص على أن دين رئيس الدولة الإسلام، وقد نظر المؤيدون لهذا النص على أنه نص يمثل هوية الأكثرية “السنّة”، وهو أمرٌ منطقي، ويرى المعارضون أن الأكثرية والأقلية هي أكثرية سياسية، ولا يوجد من يمثل أي مكوّن برمته، فثمة تباينات واختلاف في المصالح والتوجهات ضمن كل مكون، وتشترك مجموعات من مختلف المكونات في توجهاتها وفي شكل سورية المستقبلية التي تريدها، وأن الدين ليس المحدد الرئيس للهوية، فثمة قيم وعادات وتقاليد ومصالح مشتركة تشترك فيها مجموعات من مختلف المكونات يفرضها العيش المشترك، وأن النص على دين رئيس الدولة يخرق مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين، والتي نصّ عليها الإعلان ذاته، حيث تنص المادة 10 على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. ويتعارض مع أسس الدولة العصرية التي تساوي بين مواطنيها.
لكن يبدو أن من الصعب عدم النص على دين رئيس الدولة الإسلام، ليس فقط لأن اللجنة التي تم تشكيلها يتبنى أفرادها هذه القناعة، والسلطة الحاكمة ذات أيديولوجيا إسلام سياسي، بل لأن هذه القضية كانت على نحو ما حاضرة في الجدال الدائر في سورية منذ دستور الاستقلال 1950، ثم الصراع الذي دار إثر نشر مسودة دستور 1973، عندما لم تتضمن دين رئيس الدولة “الإسلام” والاحتجاجات العنيفة التي جرت في عدة مدن سورية، وخاصة في حماة.
السلطة التشريعية:
نصّت المواد 24 حتى 30 على إقامة السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، وقبل صدور الإعلان الدستوري، نصّت الوثائق والتصريحات على تشكيل مجلس تشريعي، وليس مجلس شعب، وهي التسمية الأقرب إلى كونه معيّنًا وليس منتخبًا، وانتقد خبراء ضعف استقلالية السلطة التشريعية، نتيجة التدخل الرئاسي المباشر في تشكيله، حيث لا يتم انتخاب أعضائه بالكامل، إذ يمنح الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضائه مباشرة، بموجب المادة 24، ويتم اختيار الثلثين الآخرين عبر “هيئات فرعية ناخبة”، تعيّنها لجنة عليا يشكلها رئيس الجمهورية، ولم يحدد الإعلان آلية واضحة لانتخاب هذين الثلثين، مما يفتح المجال أمام التلاعب السياسي في تشكيل المجلس، ويمنح الرئيس نفوذًا واسعًا على قراراته، سواء عبر تعيين أعضائه أو التأثير في الهيئات الناخبة. ونتيجة لذلك، تصبح السلطة التشريعية خاضعة لتوجيهات رئيس الدولة، الذي يعيّن ثلث الأعضاء مباشرة، ويتحكم في اختيار الثلثين الآخرين بشكل غير مباشر، مما يقوض استقلاليتها بشكل واضح. علاوة على ذلك، فإن اللجنة المكلفة باختيار أعضاء مجلس الشعب تبدو غير محددة المعالم في نص الإعلان، إذ لم يتم توضيح كيفية تشكيلها أو المعايير التي ستعتمدها في اختيار الأعضاء. ويثير ذلك مخاوف من أن تكون هذه اللجنة شبيهة باللجنة التي أشرفت على اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، خصوصًا أن لها دورًا حاسمًا في تحديد تركيبة مجلس الشعب، وهو المجلس الذي سيتولى عملية التشريع خلال المرحلة الانتقالية، ومن ضمن ذلك إقرار القوانين المتعلقة بالانتقال السياسي وتأمين مساره.
منح الإعلان (مادة 39) رئيس الجمهوريةحق الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ولا تقر بعدها إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، ومن المعروف أن هذه الصيغة تمكّن الرئيس من إعاقة إصدار أي قانون لا يوافق هو عليه. فعادة ما يكون مجلس الشعب مواليًا، ولا سيما أن مجلس الشعب الانتقالي تشكله لجنة يسميها الرئيس.
وعلى الرغم من أن المرحلة الانتقالية هي خمس سنوات، فقد حددت المادة 26 مدة ولاية مجلس الشعب، وجعلتها ثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، وهذا يعطي قدرة للرئيس أن يعيد تشكيل مجلس الشعب الانتقالي كل سنة ونصف مرة واحدة، مما يتيح له تعديل تركيب المجلس وإضعاف قوته، لأنه يعني أن الأعضاء المعارضين أو أصحاب الصوت المرتفع لن يجدد لهم. وحددت المادة 30 مهام مجلس الشعب المؤقت وصلاحياته، ولكنها حجبت عنه الحق في محاسبة الوزراء أو أي مؤسسة حكومية، مما يضعف سلطته الرقابية وهي من أسس مهام مجس الشعب.
السلطة التنفيذية:
أناط الإعلان الدستوري السلطة التنفيذية بالرئيس والوزراء (مادة 31)، وقيدها بالحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان، ولم يقل مجلس الوزراء، وحددت المادة 42 مهام السلطة التنفيذية. ومنح الإعلان الرئيس سلطة تعيين الوزراء (المادة 35)، ونصّت المادة ذاتها على أن رئيس الجمهورية يتولى تسمية رئيس مجلس الوزراء، وقد حسم هذا الجدل الذي دار حول وجود رئيس للوزراء، وفق النمط الفرنسي، عن حالة عدم وجود رئيس وزراء على النمط الأميركي أو التركي.
كما منح الإعلان الرئيسَ موقع القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب (المادة 31)، كما منح الرئيس سلطة إعلان التعبئة العامة والحرب وإعلان حالة الطوارئ، بعد موافقة مجلس الأمن القومي (المادة 41)، ولكن لم ينص الإعلان على كيفية تشكيل مجلس الأمن القومي وقوامه ومهامه، أي إنها متروكة للرئيس. وكان من اللافت تقييد إعلان حالة الطوارئ التي أبقاها بيد الرئيس، ولكنه قيدها بثلاثة أشهر كحد أقصى، ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب. ويأتي هذا بعد حالة سورية السابقة الفريدة في العالم، إذ أعلنت حالة الطوارئ صبيحة الثامن من آذار 1963، ولم يعلن وقفها حتى العام 2012. ومنح الإعلان الرئيس سلطة إصدار القوانين واللوائح (المادة 36)، وسلطة تمثيل الدولة وتوقيع المعاهدات مع الخارج (المادة 37). وأبقى تصديق المعاهدات الدولية بيد مجلس الشعب (المادة 31). ومنحه سلطة تعيين البعثات الدبلوماسية، وصلاحية إصدار العفو الخاص، ولم يمنحه صلاحية إصدار العفو العام، ولم يبين الإعلان الجهة التي تملك صلاحية إصدار العفو العام.
السلطة القضائية:
نصّ الإعلان على أن القضاء يتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري (المادة 45)، وأخضع القضاء العسكري لسلطة مجلس القضاء الأعلى (المادة 45)، ولم يعد تابعًا لوزارة الدفاع، مما يمثل خطوة نحو استقلال القضاء، وقد كانت صلاحياته في عهد الأسد سلطة تشمل المدنيين في قضايا مدنية لا علاقة لها بالعسكر. وكان من اللافت حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية سيئة السمعة، التي عانى منها السوريون على مدى عقود (المادة 44)، بحيث يصبح القضاء العادي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في القضايا. وعلى الرغم من أن الإعلان نص على استقلال القضاء (المادة 43)، وأن المجس الأعلى للقضاء يضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله (المادة 43)، فإن استقلالية السلطة القضائية تعد ضعيفة، لأن القضاء يعاني غياب استقلالية صريحة وقوية، حيث لم يحدد الإعلان الدستوري من يترأس مجلس القضاء الأعلى، مما يفتح الباب أمام احتمال هيمنة رئيس الجمهورية عليه، كما لم يتضمن الإعلان أي ضمانات لمنع التدخلات التنفيذية في الأحكام القضائية، مما يجعل القضاء عرضة للتأثير السياسي، ويقوض دوره كسلطة مستقلة. إضافةً إلى ذلك، منحت المادة 47 رئيس الجمهورية سلطة تعيين جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا، البالغ عددهم سبعة، على الرغم من أن الاختصاص الرئيسي لهذه المحكمة هو الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، مما يثير مخاوف جدية بشأن مدى استقلالية قراراتها. ولم يحدد الإعلان الدستوري صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وآليات عملها، وقد يُقال إن هذه التفاصيل ستُترك لتنظيمها عبر القانون، إلا أن ذلك يطرح إشكاليات كبرى، لأن آلية ممارسة المحكمة لدورها في الرقابة على دستورية القوانين يجب أن تُحسم ضمن الإعلان الدستوري نفسه، لا أن تُترك لقانون قد يكون خاضعًا لتوجهات السلطة التنفيذية. كذلك، غاب عن الإعلان الدستوري تحديد الجهة التي ستصدر الأحكام القضائية باسمها، وهو أمرٌ بالغ الأهمية، إذ إن العُرف الدستوري في الجمهوريات ينصّ على أن الأحكام تصدر “باسم الشعب”، باعتباره صاحب السيادة، وفي الأنظمة الملكية تصدر باسم الملك، بصفته صاحب السيادة. وإن ترك هذا الأمر دون تحديد يثير تساؤلات حول مصدر الشرعية السيادية في الدولة، ويرى البعض أنها ربما بتأثيرات النهج السلفي الذي يتجنب النص على أن “السلطة للشعب، وأن الشعب مصدر السلطات”، وتستخدم التوجّهات السلفية عبارات مثل “السلطة لله” أو “الحاكمية لله”، بما يعني اللجوء إلى الأحكام الدينية والشريعة والفقه في كل صغيرة وكبيرة.
“القضاء ومؤسسة القضاء” هي مقياس انتظام المجتمعات الحديثة، ويشير وضع القضاء والمؤسسة القضائية ومدى رسوخها ونزاهتها وفاعليتها واستقلاليتها إلى نوعية الحياة. وأهم مؤشرات وجود قضاء عادل وكفء ونزيه هو رسوخ ثقافة التقاضي واللجوء إلى القضاء بين الناس، وثقة الفرد أنه سينال حقوقه بعدل، وهذا يعني وجود قوانين وضعية شاملة وواضحة وشفافة، وقضاء كفء ونزيه، وقضاة مستقلين عن أي تدخل من سلطات تنفيذية، وخضوع جميع مؤسسات الدولة للقضاء حتى مؤسستي الشرطة والأمن، وعدم قدرة أي مسؤول أن يحتمي بسلطته أو أن يحتمي رجل ثري بماله من أحكام القضاء العادل، فلا سلطة فوق سلطة القضاء، وأن تكون تكاليف التقاضي في متناول كل مواطن، مهما كان دخله محدودًا.
11 العدالة الانتقالية:
يمثل إدراج نص في الإعلان الدستوري عن العدالة الانتقالية، في المادتين 48 و 49، أهمية كبيرة، حيث أظهرت تجربة الشهور الثلاث الماضية مخاطر التأخير في إحداث هيئة العدالة الانتقالية، وإصدار قانون ينظمها ويحدد مدتها وأسس الاتهام والمحاسبة، فقد راكمت الحرب السورية جبالًا من الرغبة في الثأر والانتقام، ردًا على ما قام به النظام وحلفاؤه من مجازر وقتل ودمار، ومن دون إحداث الهيئة وإصدار قانون ينظمها وإجراءات واضحة، والبدء بتنفيذ محاكمات بحق المجرمين الحقيقيين، بما يسهم في اجتثاث الرغبة في الانتقام، فإن الفوضى ستكون البديل، وهذا ما شهدناه على نطاق غير ضيق خلال الفترة السابقة، مما ترك آثارًا سلبية على استعادة السلم الأهلي. لذا من الأهمية بمكان الإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية وتشكيل هيئتها والبدء بالتنفيذ وضبط التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها. وقد كان من الأهمية بمكان أن تنص المادة 48 على إلغاء القوانين الاستثنائية ومحاكم الإرهاب، وإلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية. لكن النص لم يضمن استقلالية تامة للهيئة، ولم يوضّح مدى قدرتها على الاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الأممية ذات الخبرة لضمان حياديتها ودقة توثيقها.
ويجب أن تكون العدالة الانتقالية شاملة وتحاسب كل من تنطبق عليه شروط ارتكاب جرائم، بغض النظر عن أي طرف من أطراف الحرب. فإن نص الفقرة 2 من المادة 49 قد جاء ضد “النظام” فقط، والنظام سقط، ويجب أن تشمل المحاسبة أفرادًا محددين بأسمائهم. وعلى الرغم من وجاهة النص على محاسبة كل من يمجد جرائم النظام البائد ويبررها ورموزه أو ينكر جرائمه (فقرة 3 من المادة 49)، فإن هناك خشية من التعسف في تطبيق هذا النص، كأن يسحب على الفترات السابقة لسقوط النظام. ولا سيما أن الفقرة 2 قد أشارت صراحة إلى استثناء جرائم النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين، بما يعني إصدار قانون بخصوص هذه الجرائم ليطبق بأثر رجعي، متجاهلًا الجرائم التي ارتكبها آخرون، ولم ينص الإعلان على الجرائم التي قد تُرتكب لاحقًا بعد سقوط النظام.
12 الحقوق والحريات العامة:
كان من الجيد أن ينصّ الإعلان في عدة مواد على موضوعات الحقوق والحريات، فقد نصت (المادة 3) على أن حرية الاعتقاد مصونة، وأن الدولة تحترم جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها، ولكن تبعها نصّ “على ألا يُخلّ ذلك بالنظام العام”، وهذا يترك مجالًا واسعًا للتعسف في التطبيق، كما نصت (المادة 12) على أن الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته، ونصت على أن جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية تعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري. ومن جهة أخرى، نصت المادة 48 على إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضررًا بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان. ونصّت (المادة 13) على أن الدولة تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وهي تصون حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعدّ جرمًا يعاقب عليه القانون. ونصت على حرية المواطن في التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه. ونصّت (المادة 14) على أن الدولة تصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقًا لقانون جديد، بما يعني أن تراخيص الأحزاب السابقة تعد لاغية. وتضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات. ونصت (المادة 18) على أن الدولة تصون كرامة الإنسان وحرمة الجسد، وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، وأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، كما نصّت على عدم جواز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي، باستثناء حالة الجرم المشهود. ونصّت (المادة 19) على أن المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وهنا يخشى أن يتساهل القانون في حالات تفتيش البيوت أو أن يتم تجاوز القانون من قبل الأجهزة الأمنية المولعة بتفتيش أي شيء.
وحول حقوق المرأة، نصّت (المادة 21) على أن الدولة تحفظ المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقّها في التعليم والعمل. وتكفل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف. ولكن هذا النص تجنب استعمال كلمة “مساواة”، ونصت المادة 22 على أن الدولة تعمل على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
ويبقى المعيار هو إصدار قوانين تترجم هذه الحقوق والحريات، وتنظّم الحياة السياسية وتشكيل الأحزاب وحرية نشاطاتها في أرض الواقع، خلال فترة قصيرة قادمة، وحرية تشكيل النقابات والجمعيات وحرية نشاطها، وقوانين تنظيم حريات التعبير بشتى أشكاله المقروءة والمسموعة والمشاهدة.
وكان من اللافت، بعد كل هذه النصوص الجيدة التي نصّت على الحقوق والحريات، أن تأتي المادة (23) وإضافة إلى تقييد جميع هذه الحقوق والحريات بإخضاعها لنصوص قانونية تصدر فيما بعد، لتنصّ سلفًا على جواز إخضاعها -هذه الحقوق- للضوابط والتدابير، بذريعة “ضرورات الأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة”. وقد خبر السوريون طويلًا استخدام ذرائع الأمن الوطني لتقييد الحريات والحقوق. ومن ثم يخشون أن الإعلان قد يأخذ باليد اليمنى ما منحه من حقوق وحريات باليد اليسرى. وقد بات السوريون يشاهدون اليوم مجموعات صغيرة تجوب الشوارع أو المؤسسات أحيانًا، تعترض على مظاهر السوريين وسلوكهم في حياتهم اليومية بذرائع دينية متشددة.
13- بناء جيش وطني:
نصت الفقرة 9 من المادة 42 على بناء جيش وطني احترافي، ويفهم من هذه الصيغة “التطوع وعدم وجود خدمة إلزامية”، وجاء هذا النص انسجامًا مع قرار كانت سلطة الأمر الواقع قد اتخذته بحل الجيش الوطني، وإلغاء الخدمة الإلزامية. ويتعارض هذا التوجه مع التوجهات السورية منذ بداية الاستقلال 1946، ويعتقد الخبراء أن وجود خدمة إلزامية له ضرورات وله آثار إيجابية كثيرة، ستخسرها البلاد في حال إلغائها. فالخدمة الإلزامية في جيش وطني تنمّي الروح الوطنية السورية الواحدة، وتسهم في تعريف أبناء سورية على بعضهم على نحو أفضل وأعمق، وتعزز التعايش، وتُكسب المجنّدين مهارات إضافية.
14- المرحلة الانتقالية:
حددت المادة 52 مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية، ونصت على أن تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري، من دون أن تنص على أنها غير قابلة للتمديد، بل نصت على أن الفترة الانتقالية تنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقًا له، ففي حال عدم إقرار دستور وإجراء انتخابات وفقًا له، فإن الفترة الانتقالية ستمدد حكمًا لأجل غير مسمى. ولم يُحدد الإعلان آلية واضحة لصياغة الدستور الدائم، وكيفية تشكيل اللجنة الدستورية التي ستضع الدستور الدائم، هل ستُنتخب أم تُعيّن، ولم يوضح آلية إقرار الدستور: أستكون باستفتاء شعبي أم ستُقرّ عبر البرلمان الانتقالي، وترك الإعلان مستقبل الدستور غامضًا، مما قد يؤدي إلى خلافات سياسية تؤخر الانتقال الديمقراطي الذي لم ينص عليه الإعلان.
خاتمة:
تأتي أهميّة الإعلان الدستوري، في المراحل الانتقالية التي تلي الحروب الداخلية، من أنه يحدد الاتجاه الذي ستسير نحوه البلاد في المرحلة التالية للمرحلة الانتقالية، وهو يضع قواعد بناء الدولة الجديدة، ويكتسب النص القانوني بالمجمل أهميّة كبيرة جدًا في الدول الديمقراطية، ولدى الشعوب التي تملك ثقافة ديمقراطية عميقة، لأنه يُعدّ المحدد الفعلي والمرجع الأساس، في حين إنه يكون ذا دور ضعيف في البلدان التي تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية، ولدى الشعوب التي لا تتمتع بثقافة وتقاليد ديمقراطية، حيث تستطيع السلطة التنفيذية المتغولة أن تضرب بالنصوص عرض الحائط، سواء من خلال القوانين التي ستصدر، أو من خلال الممارسة، مهما كانت النصوص جيدة ومحددة ومقيدة للسلطة التنفيذية، ولنا في سورية أمثلة مؤلمة خلال نظام الأسد.
بدا من الواضح أن الفلسفة التي وقفت وراء صياغة البيان تهدف إلى تقديم بيان يحظى بقبول لدى أوسع فئات الشعب السوري، وأن يكون قريبًا في نصوصه ومصطلحاته من معايير الدولة العصرية قدر الإمكان، على ألا يثير في الوقت ذاته نقمة قواعد هيئة تحرير الشام وحلفائها، بمرجعياتهم الدينية التي تقوم على أسس ما زالت تقليدية لا تتفق مع مناخات الحريات العامة وقيم المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان والبناء الديمقراطي الحديث للدولة العصرية عمومًا، فجاء الإعلان بهذه الصيغة، وهي الفلسفة التي قام عليها بيان ما سُمّي بمؤتمر الحوار الوطني، ومجمل التصريحات الشفوية والمقابلات الإعلامية، التي تختلف عن الممارسة الفعلية التي تقوم على ما يسمّى “سياسة الانسجام”.
وبحسب مراقبين، كان يمكن للإعلان الدستوري أن يعزز الاستقرار واستعادة الأمن وتحقيق وحدة البلاد، والمصالحة الوطنية، وأن يُعزز ثقة الشعب بالسلطة الجديدة والعهد الجديد، وأن يخلق الثقة بين مكونات المجتمع، ويعالج المشكلات الكبرى التي خلفتها الحرب، وينزع فتيل الانتقام، ويعيد بناء المؤسسات والسير بسلام خلال المرحلة الانتقالية، تحضيرًا للمرحلة الدائمة وتهيئة الأجواء لوضع دستور دائم، وإجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، وتضع البلاد على سكة السلامة والازدهار. وهذا ما يمكن استدراكه من خلال الممارسة.
ويذهب بعض المنتقدين إلى مدى أبعد، إذ يرون أن الإعلان يفتقر إلى ضمانات كافية تحول دون تحوله إلى أداة لترسيخ سلطة استبدادية جديدة، بدلًا من أن يكون نقطة انطلاق نحو الديمقراطية، فهناك مخاوف من أن يؤدي هذا الإعلان إلى مزيدٍ من التعقيد في المشهد السوري، وربما يفتح المجال أمام مرحلة انتقالية غير مستقرة، قد تستمر من دون تحقيق تقدّم حقيقي في المسار الديمقراطي.
تحميل الموضوع
مرجز حرمون
—————————————
الصخب السوري حول الإعلان الدستوري/ ماجد كيالي
يمكن الحديث عن نواقص كثيرة كما عن إيجابيات كثيرة فيه
آخر تحديث 21 مارس 2025
لم يحظ “الإعلان الدستوري” الذي أصدرته القيادة السورية المؤقتة بإجماع السوريين. وهذا أمر بديهي، إذ لا يمكن لأي شعب أن يتوافق على كل شيء، فالتطابق سمة لدول الأنظمة الاستبدادية والشمولية.
بيد أن خصوصية التجربة السورية تحيل الخلافات الحاصلة والصاخبة بين السوريين، ليس فقط إلى خشية بعضهم من إمكان تجيير ذلك الإعلان لتعزيز النواحي السلطوية على حساب غيرها، لشعب خرج للتو من ربقة واحد من أعتى أنظمة الاستبداد، ولا بالنظر للتسرع في صوغ الإعلان، وقبله طريقة تنظيم مؤتمر الحوار الوطني، وإنما لأن السوريين مختلفون، أصلا، على أشياء كثيرة، تبعا لواقعهم وتاريخهم، وكونهم لم يتعودوا على تنظيم اختلافاتهم أو توافقاتهم، وإيجاد مخارج لها بواسطة الحوار والطرق الديمقراطية. وأيضا، لأنهم من الأساس، لم يعتادوا تعريف ذاتهم كشعب، مع الاحترام لشعار “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد”، الذي يبرز، فقط، كهتاف في المظاهرات، من دون تمثلات مناسبة له في الواقع.
تكمن مشكلة السوريين في أن نظام الأسد (الأب والابن) حرمهم أولا من الدولة التي ابتلعتها السلطة، ومن المواطنة التي تكفل صيرورتهم كشعب
ولعل أكثر أمرين افتقد السوريون لهما، طوال العقود السابقة، هما: الدولة أي دولة المؤسسات والقانون، والمواطنة أي كمكانة سياسية وحقوقية وكعلاقات فيما بينهم وما بينهم وبين الدولة. فالأولى، أي الدولة، هي شرط الديمقراطية. والثانية، أي المواطنة، هي شرط المجتمع المدني وشرط تحول السوريين- الأفراد الذين تتشكل منهم الجماعات- إلى مجتمع أو إلى شعب حقا، لذا فهما أيضا أكثر أمرين يحتاجهما السوريون في هذه المرحلة.
وتكمن مشكلة السوريين في أن نظام الأسد (الأب والابن) حرمهم أولا من الدولة التي ابتلعتها السلطة، ومن المواطنة التي تكفل صيرورتهم كشعب، فاقم منها انتهاجه سياسة “فرق تسد”، ووضع كل جماعة سورية في مواجهة غيرها، زارعا الخوف والكراهية والتنافسية السلبية فيما بينهم. أيضا، فقد حرم السوريين من السياسة، وبالتالي فهم لم يتعودوا على تقاليد المشاركة السياسية، طوال أكثر من نصف قرن، لذا فبعد أن باتوا على مسرح التاريخ، ظهر أن فائضا من الكلام لديهم، لكن من دون خبرات أو تقاليد حزبية، أو تجارب كفاحية. وتاليا فقد فاقم من كل ما تقدم أن السوريين، بعد انهيار النظام، وجدوا أنفسهم إزاء فراغ وانهيار كبيرين، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والمرجعيات، لصالح غلبة هويات أولية، إثنية وطائفية وعشائرية ومناطقية وطبقية، وكلها على حساب الهوية الوطنية.
ربما كل ذلك يفسر أن ردود الفعل ذات الطابع الشعبي على الإعلان أتت بأحكام متسرعة ومطلقة وبتحيزات مسبقة، مع توجسات مشروعة، بغض النظر عن الموقف من الإعلان سلبا أو إيجابا، تأييدا مطلقا أو رفضا مطلقا.
طبعا، يمكن الحديث عن سلبيات أو نواقص كثيرة في الإعلان الدستوري، كما يمكن الحديث عن إيجابيات كثيرة فيه، بيد أن ما يجب إدراكه، أن الأمر يتعلق بإعلان دستوري مؤقت، بمعنى أن التفاعلات القادمة بين السوريين أنفسهم، وبينهم وبين الحكم الجديد، هي التي ستحدد طبيعة الدستور القادم ومعه طبيعة الحكم.
ما يفترض إدراكه أيضا أنه ليس من الواقعي انتظار تحول سوريا دفعة واحدة من دولة استبدادية إلى دولة ديمقراطية وحريات ومواطنين. فهذا هو الأمل، بيد أن ذلك يستلزم ترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة والحريات وحقوق الإنسان في المجتمع، أي ثقافة تتأسس على إتاحة حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وحرية الأحزاب والإعلام، وهذه كلها مفتقدة في الواقع السوري، منذ ستة عقود، عدا أن الدولة ذاتها ما زالت مفتقدة فيه.
كل ما تقدم ليس له علاقة بالحكم الجديد، أين أخطأ أو أين أصاب؟ فهذا شأن آخر، لكن الحديث هنا يتعلق بالواقع المتعين في سوريا، حتى لا يبقى الكلام وقفا على وصفات إنشائية جاهزة، على شكل “روشيتات” نظرية، تنفع لأي مكان وزمان.
مثلا، ربما كان الأفضل للدستور لو نص على أن “السيادة هي للشعب” وأن “الدستور هو السلطة العليا، ولا سلطة لأحد فوقه”، وهذا مهم في دساتير النظم الجمهورية بدلالته السياسية. كما كان من المهم الإشارة ليس فقط إلى استقلالية السلطات الثلاث، وإنما النص على عدم هيمنة سلطة على أخرى، وأيضا أن النظام السياسي في سوريا ديمقراطي، وعلى أساس التداول بواسطة الانتخابات، وكذلك عدم تقييد حق ما بإجراءات سلطوية، تبعا لرغبة السلطة التنفيذية، لأن الدستور والقوانين، هي التي تنظم تلك المسائل.
مع ذلك ينبغي الأخذ بالاعتبار أن البلد يقوم من نقطة الصفر، أو ما دونه، سواء بالنسبة لقيامة الدولة، أو لقيام المواطنة/المجتمع؛ هذا أولا. ثانيا: ما يفترض ملاحظته هنا أن المسألة لا تتعلق بالنص فقط، وإنما بطبيعة السلطة، وتوجهاتها. مثلا نظام “الأسد” (الاب والابن)، قام على مبادئ “الوحدة والحرية والاشتراكية” ومقاومة إسرائيل والإمبريالية، وأن فلسطين قضيته المركزية، لكنه جعل من كل ذلك “عدة شغل”، أي للنصب والابتزاز والتسلط. وهذا دستور نظام “الأسدين” (1973-2012)، نص على أن “الجمهورية العربية السورية” دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية (م1)، وأن “السيادة للشعب” (م2) وأن مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع (م10). ونص في المادة (25) على أن الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم… المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. وفي المادة (28) بأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي… ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون… لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة”، لكن ذلك النظام دمر حياة الشعب السوري ودمر سوريا.
أيضا، فإن مشكلة السوريين في نقاشاتهم حول الإعلان، أنهم يبدون كأنهم يقفون في خندقين متقابلين، الموافقون ضد المعترضين وبالعكس، ومن ليس معنا ضدنا، إما وطني أو عميل، وهذا غير صحي البتة، وهذا ضد مبدأ الحرية الذي ضحى من أجله السوريون، وضد مبدأ الديمقراطية، وبخاصة أن كل طرف يدعي أنه يمثل الشعب أو أنه كل الشعب!
المجلة
———————————
سوريا إلى أين؟/ بكر صدقي
تحديث 21 أذار 2025
من واكب التطورات السياسية في سوريا ما بعد نظام الأسد لا يخفى عليه تخبط المجموعة الحاكمة الجديدة أمام التحديات الهائلة التي خلّفها النظام المخلوع. بات وراءنا الآن أكثر من ثلاثة أشهر لم تسجل خلالها الإدارة الجديدة أي تقدم في أهم الملفات كالأمن والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي وتفكيك الفصائل المسلحة وتوحيد الجغرافيا السورية والمجتمع السوري.
لقد انبهرت هذه السلطة بسرعة توليها السلطة في اثني عشر يوماً، وبالقبول العربي والإقليمي والدولي الواسع والسريع بها، كما بقبول غالبية اجتماعية قام قبولها على الالتفاف حول الإنجاز الكبير المتمثل في إسقاط النظام. وفي حين تدين السلطة لسرعة إسقاط النظام بظرف إقليمي استثنائي هو ارتدادات عملية «طوفان الأقصى» وتداعياتها الكارثية، قام القبول العربي ـ الإقليمي ـ الدولي على رغبة الدول المعنية باستعادة الاستقرار الذي طال غيابه 14 عاماً وتسبب بتداعيات خطيرة وصلت آثارها إليها، كمشكلات الإرهاب وتدفق اللاجئين والمخدرات والأعباء الاقتصادية المرتبطة بها. أما القبول السوري العام فكان أساسه الفرح العارم بسقوط النظام وما عناه ذلك من انفتاح الأفق أمام تأسيس جديد يقطع مع الماضي الكارثي، إضافة إلى الأداء المقبول لهيئة تحرير الشام وحلفائها أثناء عملية «ردع العدوان» وبخاصة في مناطق حساسة كحلب ودمشق وجبال الساحل، حيث لم تشهد المعركة عمليات انتقامية واسعة النطاق أو أعمال عنف على أساس طائفي أو تضييقاً واسع النطاق على الحريات العامة والخاصة.
غير أن كل ذلك راح ينقلب إلى تراجع في شعبية الفريق الحاكم بمرور الأيام، بدءاً بمسرحية «مؤتمر الحوار الوطني» الهزلية وصولاً إلى المجازر الطائفية في الساحل مع الأسبوع الأول من شهر آذار الجاري، وأخيراً إصدار الإعلان الدستوري الذي لاقى انتقادات واسعة، فطغى على المشهد السياسي غياب الثقة بين قطاعات واسعة من المجتمع لا تقتصر على العلويين أو الأقليات، مقابل ارتفاع منسوب العدوانية اللفظية لدى مؤيدي السلطة الجديدة في مواجهة أي نقد لمسالكها حتى فيما اعترفت بها هي نفسها وشكلت «لجنة تقصي حقائق» بشأنها. مجمل القول هو أن الرصيد الكبير (المشروط) الذي حصلت عليه السلطة الجديدة في الداخل والخارج آخذ في التآكل كل يوم مع تراجع الآمال التي عقدت على التحول الكبير الذي تمت المراهنة عليه.
لن أدخل في تفاصيل نقد الإعلان الدستوري الذي قام به كثر وشمل مختلف مفرداته، ولكن من الطريف الإشارة إلى بند يتعلق برئاسة الجمهورية حيث ورد فيه شرط يتعلق بدين رئيس الجمهورية من غير أي إشارة إلى جنسيته، ربما لأن اللجنة الدستورية التي عينها الشرع لم تخطر ببالها هذه الثغرة الخطيرة حتى لو تعلقت باحتمال قريب من الصفر. فوفقاً لهذا الشرط يمكن لأي مسلم أن يشغل منصب رئاسة الجمهورية حتى لو كان غير سوري الجنسية، مع العلم أن هيئة تحرير الشام وفصائل جهادية أخرى فيها أعضاء أجانب من جنسيات مختلفة، وبينهم من تم تجنيسهم على عجل وبصورة غير معلنة!
لعل غموض أجندة الفريق الحاكم، وبخاصة قائده أحمد الشرع، في مسائل أساسية كشكل الدولة ونظام الحكم وغيرها، هو ما شجع كثيرين على المراهنة على تغيير لا بد أن يطال برنامجهما الأيديولوجي المعروف القائم على الفكر السلفي والنزعة الطائفية السنية. لكن هذا الغموض لم ينجلِ في الفترة المنصرمة إلا عن أسوأ الكوابيس التي استبعدها السوريون، فتفجر العنف الطائفي واتضحت الميول السلطوية والإقصائية من غير أن يظهر ضوء في نهاية النفق حتى لو كان طويلاً بحكم حجم المشكلات الهائل وضعف وسائل معالجتها.
وعلى رغم هذه المؤشرات المقلقة، يبقى أن السلطة ما زالت ضعيفة وهشة (وهذا بدوره مقلق) وخاضعة لاشتراطات كثيرة أغلبها للأسف خارجي، ستكون مرغمة على التعاطي الإيجابي معها لاستكمال شرعيتها المنقوصة، ولحل مشكلة العقوبات المفروضة على سوريا التي لا تسمح بإطلاق عجلة الاقتصاد، ولا يمكن للسلطة أن تحافظ على ما تبقى لها من شعبية قبل ذلك.
تطفو على السطح، في الحراك الاجتماعي السوري، مشكلة «المكوّنات» التي فشلت السلطة في إدماجها لأنها لم تر في السوريين إلا مكوّنات طائفية وعرقية وثقافية وسعت إلى التحايل عليها بدلاً من معالجتها بروح وطنية. بدا الاتفاق الذي وقعته السلطة مع قسد وكأنه «تاريخي» في أعقاب مأساة أهل الساحل، لكن الإعلان الدستوري بالصورة التي صدر بها قد أضعف من تاريخيته المحتملة، فلا رضيت عنه قسد ولا تيار وازن من دروز السويداء بقيادة الشيخ حكمت الهجري.
لا يمكن للمغمغة بشأن ديمقراطية الدولة وعلمانيتها، وهما شرطان لازمان لقيام دولة في سوريا تمثل جميع مواطنيها، أن تؤسس لهذه الدولة المأمولة، حتى لو تجنب أركان السلطة الكلمتين بذاتهما بحكم الإيديولوجيا التي تحكم تفكيرهم. ما لم تمض السلطة في هذا الاتجاه، ولو بخطوات بطيئة، نخشى سيناريوهات كارثية كتقسيم البلاد أو الحكم بالعنف المعمم مع شعبوية قاتلة. ويحتاج الفريق الحاكم إلى تحالف عريض مع فئات اجتماعية واسعة ليتمكن من تأسيس شرعيته. في حين أن الاستفراد بالسلطة والعجز عن تفكيك الجماعات المسلحة وتوحيد مناطق البلاد هو السائد إلى الآن. سوريا ليست بخير.
كاتب سوري
القدس العربي
——————————-
“تداول آراء” في أولى جولات التفاوض بين دمشق و”قسد”/ محمد أمين
21 مارس 2025
بدأت جولات تفاوض بين الحكومة السورية من جهة، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من جهة ثانية، من أجل تنفيذ مضامين اتفاق وُقّع أخيراً بين الطرفين في دمشق، بهدف دمج هذه القوات في المنظومة العسكرية للبلاد، واستعادة الدولة السيطرة على الشمال الشرقي من سورية. فقد عُقدت أولى جولات التفاوض، أمس الأول الأربعاء، بحضور قائد “قسد” مظلوم عبدي، ومسؤولين أميركيين، في القاعدة العسكرية بمدينة الشدادي بريف الحسكة. وبحسب مصادر مطلعة، عقدت ثلاث جلسات خلال الجولة الأولى من مفاوضات دمشق و”قسد” منها جلسة بين الوفد الحكومي وفريق أميركي، من دون مشاركة ممثلين عن “قسد”. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الفريق الأميركي ذكر لوفد الحكومة السورية أنهم متعاونون (الجانب الأميركي) بأعلى المستويات لإحلال السلام على الأراضي السورية، وطالب الوفد “قسد” بتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بالتفاوض، حسين السلامة، في تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، مساء أمس الأول، أن “النقاش جرى من منطلق المسؤولية الوطنية، وبإرادة مشتركة تهدف إلى وحدة الأراضي السورية وتشمل جميع المكونات من دون إقصاء أحد”. وأضاف: “اتفقنا خلال الاجتماع الأولى على تشكيل لجان عمل متناظرة تخصصية، ستبدأ عملها بداية شهر إبريل/نيسان المقبل”، موضحاً أن عملها سينحصر على “تقريب وجهات النظر وإعداد خريطة طريق لتوحيد الأراضي السورية”.
في السياق، ذكرت “قسد” في بيان، أمس الأول، أنه “جرى تداول للآراء خلال الاجتماع”، مشيرة إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع للإعلان الدستوري (وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع يوم 13 مارس/ آذار الحالي) والحاجة لعدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سورية وكتابة دستور”. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقّع في دمشق يوم 10 مارس/ آذار الحالي، اتفاقاً مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، نصّ على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وعلى وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية. كما أكد الاتفاق أن “المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور”. ونص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سورية التابعة لـ”قسد”، ضمن إدارة الدولة السورية.
الرفض الكردي للإعلان الدستوري يخيّم على اتفاق “قسد” ودمشق
نزع هذا الاتفاق مع “قسد” فتيل توتر على الساحة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقطع الطريق أمام صدام عسكري كان يخشى منه السوريون لحسم مصير الشمال الشرقي من سورية، الغني بالثروتين الزراعية والنفطية. تعاطت الإدارة الجديدة في سورية مع ملف الشمال الشرقي بالكثير من “الهدوء” لتجنيب البلاد دورة عنف جديدة يمكن أن تجر البلاد إلى صدام واسع النطاق على أساس عرقي. واتفق الطرفان، أي الرئاسة السورية وقوات قسد، على الخطوط العريضة، والمبادئ العامة للاتفاق، إلا أن هناك الكثير من التفاصيل التي ربما ستتطلب جولات كثيرة من التفاوض لحسمها، خصوصاً لجهة الوضع النهائي لقوات قسد التي تطالب بدخول الجيش السوري كتلةً واحدة وبقائها الجهة المسيطرة على الشمال الشرقي من سورية.
ملف المقاتلين الأجانب
في المقابل، تصر الإدارة السورية على دخول إفرادي لعناصر هذه القوات التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب” الكردية، والتي يُنظر إليها على أنها الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني، والذي ما تزال كوادره تتحكم بالكثير من مفاصل القرار في شمال شرقي سورية. وربما سيكون ملف المقاتلين الأجانب في صفوف “قسد” والمنتمين إلى “العمال الكردستاني”، معضلة أمام إنجاز اتفاق نهائي بين دمشق و”قسد”. فقد أكد قياديون في تلك القوات، بمن فيهم مظلوم عبدي، أن هؤلاء المقاتلين سيغادرون سورية في حال إتمام الاتفاق مع دمشق. ولا معلومات وإحصائيات يمكن الركون إليها عن عدد المسلحين الأجانب في صفوف “قسد”، إلا أن تقارير إعلامية تتحدث عن ثلاثة آلاف عنصر من أكراد العراق وتركيا وإيران، دخلوا سورية على مراحل. وتصر الإدارة السورية على خروج هؤلاء المسلحين من الأراضي السورية لتفادي تهديدات تركية بالتدخل العسكري في الشمال السوري لإجبار “قسد” على تسليم السلاح.
وقد زوّد التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة “قسد” بأسلحة نوعية خلال الحرب التي خاضتها هذه القوات ضد تنظيم داعش منذ تأسيسها في عام 2015، وصولاً إلى مطلع عام 2019، حين أُعلن عن هزيمة التنظيم في منطقة شرقي نهر الفرات. ومن المرجّح أن يكون مصير هذا السلاح، خصوصاً الثقيل منه من المسائل التي ستطيل عمر المفاوضات، لا سيما أن “قسد” تريد الاحتفاظ بسلاحها. وكان الاتفاق الذي أبرم بين الرئاسة السورية و”قسد” قد نصّ أيضاً على “دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها”، لذا من المتوقع أن تُسند إلى “قسد” مهام من وزارة الدفاع السورية خارج الشمال الشرقي من سورية، في حال التوصل لآليات تنفيذ الاتفاق. ورغم أن الاتفاق بين دمشق و”قسد” ذو طابع عسكري، إلا أنه من المتوقع أن تحاول هذه القوات ربط تنفيذ الاتفاق بالحصول على مكاسب سياسية للأكراد السوريين، في الدستور الدائم الذي من المفترض إنجازه في منتصف المرحلة الانتقالية والمقدرة بنحو خمس سنوات.
عراقيل أمام اتفاق دمشق و”قسد”
رأى المحلل السياسي المقرب من الإدارة الذاتية (شمال شرقي سورية)، إبراهيم مسلم، في حديث مع “العربي الجديد”، أن هناك عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق الذي وُقّع بين الشرع وعبدي “منها القصف المتكرر من قبل الجانب التركي على الشمال السوري وعدم اتخاذ الإدارة الجديدة موقفاً رافضاً لهذا القصف الذي يفضي إلى مقتل مدنيين”. وبرأيه “هناك خطاب كراهية تجاه الأكراد في سورية، أعتقد أنه سيكون إحدى العراقيل أمام الاتفاق”، مضيفاً أن “قسد قدمت تنازلات من أجل الاتفاق، ولكن تنفيذه يحتاج إلى وقت، فالأمر مرتبط بالظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالملف السوري”.
عناصر من “قسد” بدير الزور،4 سبتمبر 2023(دليل سليمان/فرانس برس)
وفي السياق، رأى المحلل السياسي بسام السليمان، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “أصعب القضايا كما يبدو لي هي دمج قوات قسد في الجيش السوري الجديد”. وباعتقاده فإن “ملف الإدارة الذاتية التي شكلتها قسد سيكون من القضايا الصعبة، خصوصاً أن لدى هذه الإدارة نحو 150 ألف موظف يجب دمجهم في مؤسسات الدولة”. كما اعتبر أن ملف “داعش” ومواجهته، فضلاً عن إدارة السجون التي تضم أسرى التنظيم سيكون حاضراً بقوة على طاولة التفاوض بين دمشق و”قسد”. وبرأيه فإن “الحضور الأميركي في هذا الملف سيظل موجوداً ريثما ينتهي ملف التنظيم بشكل كامل، سواء أنجز اتفاق بين دمشق وقسد أو لم ينجز”. وتوقع السليمان أن يكون مسار التفاوض طويلاً بين الطرفين، موضحاً أن “اتفاق دمشق كان اتفاقاً على المبادئ”، والأمر “يحتاج إلى الكثير من الحوار وخطوات بناء الثقة المتبادلة”.
العربي الجديد
——————————
=====================