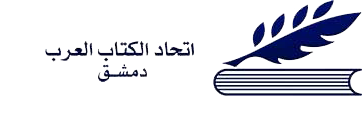الشعر المترجم إلى العربية: ما بين الانتشار والاستخفاف/ مناهل السهوي
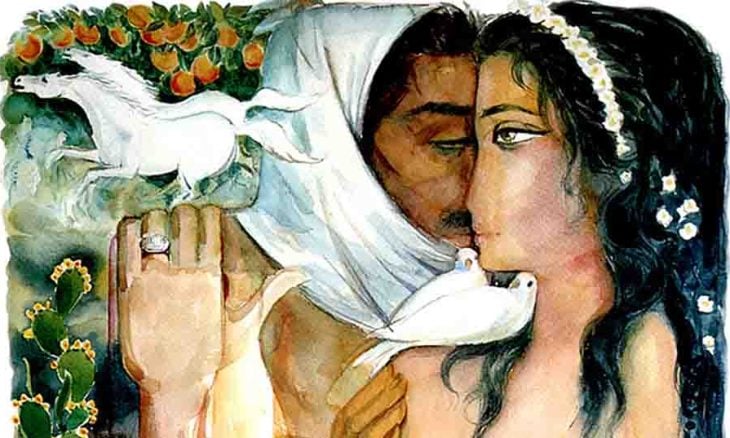
27 مارس 2025
في السنوات الأخيرة، ازداد الإقبال على قراءة الشعر المترجم إلى العربية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بات تناقل القصائد المترجمة أكثر شيوعًا من تداول القصائد المكتوبة بالعربية. في المقابل، يواجه الشعر المترجم أحيانًا نظرة استخفاف، بل وتُتهم بعض النصوص العربية الحديثة بأنها أشبه بترجمات ضعيفة!
يطرح هذا الواقع تساؤلات حول سبب انجذاب الجمهور إلى الشعر المترجم، ولماذا يُنظر إليه أحيانًا على أنه أقل عمقًا أو جودة، وهل كان للترجمة أثر في تطوّر الشعر العربي؟ في هذا التحقيق، نحاور عددًا من المترجمين العرب من لغات مختلفة، مثل الفرنسية والإنكليزية والإيطالية، بهدف استكشاف رؤاهم حول الشعر المترجم وتأثيره.
أسامة إسبر: من نقرأ في الترجمة، الشاعر أم المترجم؟
لا تصمد على حلبة القراءة الحقيقية إلا ترجمات تهرب من قيود الحرفية والنقل المباشر، أو “الإخلاص” في نقل المعنى. هناك ترجمات سحرت القراء، لا لأنها أخلصت في نقل النص الأصلي من لغته الأجنبية، بل لأنها منحته جناحين حلّق بهما إلى أعلى في اللغة التي تُرجم إليها. أيد هذا الرأي نقادٌ وشعراء ومفكرون كبار عرّفوا الترجمة من لغة إلى لغة بأنها إعادة إبداع للنص الأجنبي قائمة على التأويل، وليست مجرد تمرين لغوي في النقل.
الخيارات التأويلية للمترجمين تصوغ كيفية تلقي النصوص في اللغة المترجم إليها. فالترجمة تأويل وتفاوض بين اللغات والثقافات، كما يقول الشاعر المكسيكي الكبير أوكتافيو باث. يعرّف باث ترجمة الشعر بأنها فعل إبداع وتأويل، مؤكدًا على ضرورة تأويل الخصائص الفنية والعاطفية للنص الأصلي لتحقيق ترجمة مهمة في اللغة المنقول إليها. الشاعر أدونيس أكّد أيضًا في كثير من حواراته الصحافية والتلفزيونية على الترجمة كإعادة تأويل وخلق انطلاق من النص في لغته الأجنبية الأصلية حتى لو أدى هذا إلى إعادة تأليفه بشكل لا ينسجم مع أصله، ويبتعد عنه لكن ضمن مناخه، وكان أدونيس، في كلامه هذا، يدافع عن ترجمته لقصائد سان جون بيرس وإيف بونفوا.
لا تُقاس أهمية الشعر، حتى في صيغته المترجمة، من منظور إقبال الجمهور أو عزوفه لكن النص المترجم بطريقة شعرية عالية يعثر دومًا على قرائه.
إن سبب النظرة للشعر المترجم أنه أقل جودة هو قلة الترجمات العظيمة. ثمة غزارة في ترجمة الشعر عربيًا عن اللغات الأخرى إلا أن عددًا قليلًا منها يخترق البعد الأفقي للترجمة ويقدم نصًا متفردًا.
إن السؤال الذي يُطرح، وأرى أنه جوهري: من نقرأ في الترجمة، الشاعر أم المترجم؟ لنأخذ مثالًا ترجمة أدونيس لسان جون بيرس التي أثارت الجدل عربيًا. إن أدونيس لا يترجم بقدر ما يؤول ويعيد الكتابة، حتى أن الذين قارنوا بين النص العربي والأصل الفرنسي للقصائد لم يجدوا صلة في كثير منها، وانتقدوا أدونيس. لكن نقاده أغفلوا أنه لم يترجم بيرس بإخلاص تام للأصل بل أعاد إبداع قصائده في العربية، وفي إطار خصوصيتها الجمالية. إن من يقرأ “منارات” و”منفى وقصائد أخرى”، ويقارن نصوصهما مع الأصل الفرنسي، إذا كان يعرفه، سيجد فرقًا كبيرًا بين بيرس الفرنسي وبيرس العربي إلا أنه سيشعر بقوة شعره في العربية وقد اتخذت أبعادًا جديدة ما يؤكد على أن الترجمة خلق وإبداع أكثر مما هي نقل، بل تتجاوز النقل إلى العثور على محرّضات داخل النص الأصلي تقود إلى عوالم شعرية جديدة.
ولا شك في أن هذا ما يجعل ترجمة الشعر مهمة شاقة، فمهما برع المترجم لن يستطيع الاقتراب من الأصل، خاصة أن لكل لغة تاريخها الجمالي وخصوصيتها التعبيرية انطلاقًا من الاختلاف الذي يشكله كلّ شاعر في لغته الأصلية. إلا أن هذه المغامرة في النقل، أي الترجمة كإعادة تأليف وإبداع، هي التي تنقذ الشعر المترجم، وتجعل شعراء اللغات الأخرى، مقروئين شعريًا في لغة الضاد، في ما لا يبدو ترجمة بقدر ما يبدو شعرًا جديدًا مكتوبًا من جديد انطلاقًا من النصوص الأصلية. من دون هذه المغامرة التعبيرية، وإعادة الخلق التي تحلّق بالنص المترجم في آفاق اللغة الجديدة لن تكون الترجمة أكثر من نسخة باهتة عن الأصل.
كان للترجمة دومًا تأثير كبير في تجارب شعرية معينة. على سبيل المثال ناقش الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث كيف أن الترجمة ليست مجرد مهمة لغوية بل هي فعل إبداعي. يزعم باث أن ترجمة الشعر تنطوي على عملية إعادة خلق، ما يسمح للشعراء باستكشاف أشكال ومعان جديدة. هكذا يصبح المترجم مشاركًا في الإبداع، وهذا يمكن أن يؤثر على أسلوبه الشعري الخاص، إذا كان شاعرًا. وإذا ما نظرنا إلى حركة الحداثة في الشعر العربي سنجد أن الشعر العربي في ذرواته التعبيرية العليا، هو نتاج الاطلاع على تجارب شعرية في لغات أخرى بدءًا من إليوت وسان بيرس وصولًا إلى الشعراء الأميركيين الشماليين، والأميركيين الجنوبيين وغيرهم من شعراء العالم الكبار. كي يكون الانفتاح على شعر الشعوب الأخرى فعالًا ومنتجًا نحتاج إلى أن نؤمن بالترجمة كإعادة خلق تحلق بالنص المترجم في آفاق تعبيرية جديدة في اللغة التي يُترجم إليها.
(أسامة إسبر: شاعر ومترجم وفوتوغرافي سوري مقيم في أميركا، ترجم نحو 40 كتابًا عن الإنكليزية)
ستيفاني دلّال: الجمهور ينجذب إلى التريند
أكثر ما يجذب القرّاء، خاصة في العالم العربي، هو الأسماء الشهيرة أكثر من الموضوعات أو الثقافات أو اللغات. ويتركز الاهتمام غالبًا على الأدب المكتوب بالإنكليزية لسهولة الوصول إليه، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حاليًا، يلقى الشعراء الحديثون رواجًا واسعًا، بغض النظر عن جودة أعمالهم.
أصبح الجمهور ينجذب إلى ما هو رائج (التريند) بدلًا من اختيار قراءاته وفق اهتماماته. فبدلًا من البحث عن نوع معين من الأدب، يعتمد الكثيرون على شهرة الكاتب. مثلًا، قد لا يكون الشخص قارئًا للشعر، لكنه يعرف أسماء مثل روبي كور أو لانغ ليف، لأن أعمالهما منتشرة بكثرة على الإنترنت، رغم قلة الترجمات القوية لها، حيث يعتقد كثيرون أن مجرد معرفة بسيطة بالإنكليزية تؤهلهم للترجمة.
لهذا، حين ترجمتُ كتابي “الرحيل فنٌّ سهل التعلم”، حرصتُ على البحث عن شاعرات حديثات لم يُترجَم لهن كثيرًا، رغم أن بعضهن يتمتعن بشهرة واسعة. فالشهرة عامل جذب بلا شك.
ترتبط النظرة السائدة بأن الشعر المترجم أقل جودة بطبيعة الترجمة نفسها، إذ يفقد النص بعضًا من روحه عند نقله إلى لغة أخرى بسبب اختلاف المفردات والتراكيب الثقافية، ما يجعل الترجمة الحرفية تضعفه، خاصة في الشعر، الذي لا يمكن عزله عن سياقه.
لذلك، كنت أحرص عند الترجمة على قراءة الديوان كاملًا لفهم موضوعه العام، لأن معرفة تجربة الشاعر أساسية لنقل النص بدقة. مثلًا، وجدت أن إحدى الشاعرات كتبت تحت تأثير علاقتها المعقدة بوالدتها، وأخرى عكست نصوصها مشاعر الاغتراب بسبب الهجرة.
كما أن الغموض في تحديد المخاطَب في النصوص الإنكليزية يفتح مجالًا للتأويل، ما قد يؤثر على الترجمة، خاصة في موضوعات غير مقبولة في سياقات معينة، كالعلاقات المثلية. أحيانًا اضطررت لاستبعاد قصائد لهذا السبب.
إلى جانب ذلك، تتغير بنية القصيدة وإيقاعها في الترجمة، لكن ولأني شاعرة، سعيت للحفاظ على روح النصوص الأصلية قدر الإمكان حتى لا تفقد تأثيرها عند نقلها إلى العربية.
الأسلوب الغربي الحديث في الشعر بات يعتمد على إدخال كلمات عامية ومصطلحات جديدة، مع تفكيك البنية اللغوية التقليدية، حيث تُقسَّم الجملة الواحدة إلى كلمات قصيرة تُعتبر شعرًا.
إلى جانب الأسلوب، تختلف المواضيع جذريًا، فكثير من القضايا المطروحة تُعدّ “تابوهات” في مجتمعاتنا، ما يجعل نشرها خاضعًا للرقابة أو غير مقبول. لذا، يصعب أحيانًا تقبل الشعر الحديث مترجمًا، نظرًا لاختلاف السياقات الثقافية.
عند الترجمة، وجدت أن بعض النصوص قد لا تلقى قبولًا، ليس فقط بسبب مواضيعها، بل أيضًا لطريقة معالجتها. في الشعر الغربي، هناك حرية في تناول التجارب الشخصية دون قيود، بينما في العالم العربي، قد يُنظر إلى الجرأة على أنها استفزاز أو سعي للشهرة. قلة فقط ينجحون في تناول هذه القضايا بأسلوب شاعري بعيد عن الابتذال، بدون الاعتماد على الصدمة وحدها لكسر المحظورات.
تأثير الثقافة واضح، فالشاعرات في بيئات تفرض قيودًا صارمة يجدن أن تناول المواضيع الحساسة قد يؤدي إلى سوء فهم أو تبعات سلبية، سواء أكانت هذه المواضيع تتعلق بالتابوهات، السياسة، أو أي قضية قد تسبب لهن “وجع رأس”. لذلك، يتركز ما يُكتب ويُنشر غالبًا حول المشاعر والحب، بينما تبقى موضوعات أخرى محاطة بقيود اجتماعية وثقافية.
لا تزال النساء في مجتمعاتنا يفتقدن المساحة الكافية للكتابة بحرية تامة، كما أن ثقافة التعبير عن الذات بلا قيود لم تترسخ بعد بشكل كامل.
تؤثر الترجمة على هيكل القصيدة بالكامل، إذ تُفقدها بنيتها الأصلية، مما يجعل الحفاظ على جودتها تحديًا صعبًا. ورغم أن الوصول إلى ترجمة مثالية مستحيل، إلا أن الحفاظ على أكثر من 60% من روح النص وجودته، مع إخراجه بشكل مقبول بالعربية، يُعد إنجازًا كبيرًا.
الفارق الحقيقي يكمن في قدرة المترجم على التقاط أسلوب الشاعر بحيث تُقرأ الترجمة كنص إبداعي قائم بذاته. عندما تؤثر القصيدة المترجمة في القارئ وكأنها كُتبت بالعربية، فإن ذلك يسهم في تطوير اللغة، ويُفسح المجال لمعانٍ جديدة. في ظل التطور السريع للغات، يمكن للترجمة الإبداعية أن تثري العربية بمصطلحات تحاكي أفكارًا غير متداولة من قبل.
(ستيفاني دلال: شاعرة ومترجمة سورية، ترجمت عن الإنكليزية مختارات شعرية لشاعرات بعنوان “الرحيل فنٌّ سهل التعلُّم”).
كاصد محمود: قصيدة النّثر جعلتْ للشعر العالميّ أرضيّة مشتركة
ثمّة جوهر إنساني للشّعر، تشترك فيه كلّ اللّغات والثّقافات. فالتّجربة الإنسانيّة، وإنْ اختلفتِ الانتماءات الثّقافيّة والحضاريّة، تبقى الحجر الأساس الّذي يقوم عليه الشّعر. ولعلّ هذه التّجربة هي بالذّات ما يبحث عنه القارئ، فيتماهى معها حينًا، ويجعلها مرآة له حينًا آخر. ولا شكّ في أنّ الانتماء الثّقافيّ المختلف يجعل الشّعر أكثر ثراءً، لما يحمل في طيّاته من عناصر تمنح القارئ فرصة اكتشاف الآخر، وبالنّتيجة اكتشاف نفسه أيضًا. إضافة إلى هذا كلّه، فالاطّلاع على الشّعر المترجم عن اللّغات الأخرى يمثّل، أيضًا، دراسة لمسار الشّعر العالميّ، واكتشافًا للتّغيّرات الطّارئة عليه.
لا أحسب ترجمة الشّعر بالأمر اليسير، إذْ تتمثّل في إعادة كتابة النّص شعريًّا. ولعلّ هذا ما دفع الكثيرين إلى القول إنّ مترجم الشّعر يجب أنْ يكون شاعرًا. وترجمة الشّعر، كما هي حال كتابته، إنّما هي سعي لبلوغ نصّ عالي الجودة، في المعنى وفي اللّغة. وبطبيعة الحال، تختلف نتيجة هذا السّعي باختلاف قدرات المترجم وإجادته لعمله، وامتلاكه للأدوات الضّروريّة. على أنّ المعادلة ذاتها تنطبق على الشّاعر أيضًا. بل نجد في نفس التّجربة الشّعريّة للشّاعر الواحد نصوصًا متفاوتة في القوّة والعمق. وأظنّ أنّ هذا جزء من التّجربة الإنسانيّة. لذا، فمن الطّبيعيّ أنْ نجد نصوصًا شعريّة مترجمة، أو أصليّة، تختلف في جودتها وعمقها عمّا سواها. فالمسألة إذًا لا تتعلّق بشيوع الصّورة، بقدر ما هي حقيقة واقعيّة. ويجدر بي الإشارة إلى أنّني لا أتحدّث عن التّرجمة الضّعيفة، أو السّيّئة، فهذه مسألة أخرى.
قلتُ إنّ للشّعر جوهرًا إنسانيًّا تشترك فيه كلّ اللّغات، وبإمكاني القول إنّ شكل القصيدة اليوم تشترك فيه، بصورة ما، كلّ اللّغات. فقصيدة النّثر جعلتْ للشعر العالميّ أرضيّة مشتركة. مع هذا فالاختلاف في الأساليب وتأثير الثّقافة والتّراث أمر طبيعيّ. تختلف بنية كلّ لغة عن غيرها من اللّغات، ولهذا تأثيرات على مستوى بناء النّص وموسيقاه. كما يختلف العروض وقوانينه بين لغة وأخرى (ولا أعني هنا فقط الشّعر القديم، بل أيضًا التّجارب الشّعريّة المعاصرة وتأثيرات القوانين العروضيّة الكلاسيكيّة عليها من قريب أو من بعيد). ثمّ إنّ كلّ شعر إنّما هو وليد بيئته وثقافته وجذوره التّاريخيّة. فعلى سبيل المثال، الشّاعر العربيّ الّذي يلمح، في نصّه، إلى خيانة أخوة يوسف، قد يجعل نصّه، في الغالب، مغلقًا بالنّسبة لقارئ غربيّ. كما أنّ للشّاعر الغربيّ قصصه الدّينيّة وأساطيره المحلّيّة الّتي قد يجهلها القارئ العربيّ. في النّهاية، ثمّة دائمًا أمر يجهله قارئ نصّ من ثقافة أخرى، ولكن، ألا يكمن في هذا جمال الاكتشاف والمعرفة؟
أمّا من ناحية المواضيع، فهذا أيضًا فيه اختلاف وتشابه. فالشّاعر وليد بيئته وظروفه الاجتماعيّة والحياتيّة. وبكلّ تأكيد ثمّة اختلاف دائمًا، صغيرًا كان أو كبيرًا، بين تجربة من يعيش الحروب وتجربة من يعيش السّلام والرّخاء. ولكن، لا يندر أبدًا أنْ نجد شاعرًا أوروبّيًّا يكتب أيضًا عن مأساة بلد عربيّ بعيد.
لقد أثّرتِ التّرجمة، خصوصًا في القرن المنصرم، على تطوّر الشّعر العربيّ بنحو كبير، بل أدّتْ إلى إحداث تغييرات جوهريّة، سواءً في مضامينه أمْ في شكله. فمنذ عصر النّهضة، تأثّرتِ الحركات الشّعريّة في العالم العربيّ بالحركات الشّعريّة في أوروبّا، بدءًا من الحركة الرّومانسيّة وليس انتهاءً بالشّعر الحرّ. وما زال الشّعر المترجم يلعب دورًا كبير في التّأثير على مسار الشّعر العربيّ. وإنْ أمكننا القول اليوم إنّ التّجربة العربيّة تسير إلى جانب التّجربة العالميّة، فهذا لا يعني، بحال من الأحوال، أنّها استغنتْ عن غيرها من التّجارب. فحينما تكون هناك تجارب عالميّة جديدة، أو أساليب مستحدثة، فإنّ التّرجمة هي الأمل الوحيد في نقل هذه التّجارب والأساليب، وإلّا فسنبقى حبيسي تجربتنا، ندور فيها كمن يدور في دائرة مغلقة. التّرجمة، إذًا، هي صنو الحرّيّة والتّجديد والثّراء، وسيبقى تأثيرها ما بقي الشّعر.
(كاصد محمود: مترجم عراقي وأستاذ اللغة والأدب العربي في جامعة بولونيا الإيطالية، له العديد من الترجمات والمؤلفات باللغتين العربية والإيطالية).
ضفة ثالثة