في تفسير السجن لمعنى الحرية/ وارد بدر السالم
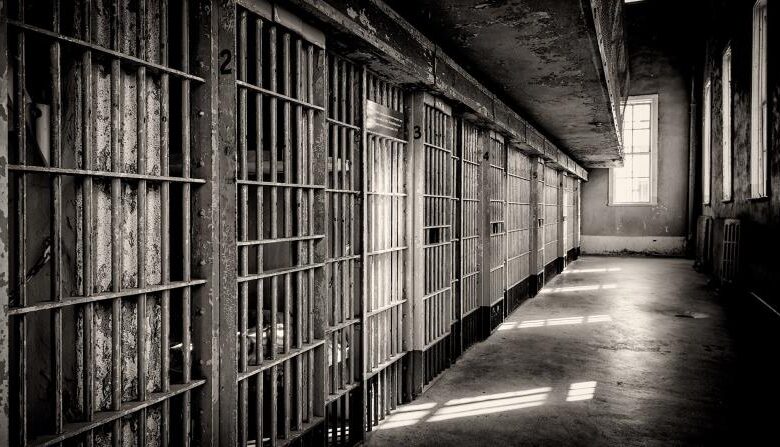
27 مارس 2025
(1)
السجن من الأمكنة المحشورة في مكان عام.
السجون ضيقة جدًا حتى وإن توسعت وشغلت مساحات كبيرة من الأرض. هي ليست بيوتًا تعيش وتستكين فيها حيواتٌ متطامنة بهذا المعنى، انما؛ واقعيًا؛ أقفاص اسمنتية مسلّحة معبّأة بالحراسة المشددة. لا توجد فيها مسامات جاذبة لشرائح الهواء والرياح والأصوات وفوضى الخارج. مستطيلة الشكل على الأغلب. كما لو أنها توابيت لكائنات أسطورية. نستطيع القول بأنها ورش كبيرة لطحن الأحلام والآمال وتفتيتها، مع أن السجين أكثر الناس حلمًا وأحلامًا بالحرية المفقودة. فهذا المكان لا يصلح للعيش الطبيعي كونه استثناءً في الحياة. وممخضة لتوليد الطاقات السلبية وإشاعة اليأس وإحباط الرغبات الإنسانية، ومحاصرة الإنسان تحت طائلة القانون. لهذا نجد أن ثيمة السجن انتشرت كثيرًا في القصص والروايات والأفلام السينمائية؛ كونها تعالج مشاكل الإنسان وجرائمه المتعددة؛ وهي تقدم المكان والمُستَمكنين فيه بأفضل الطرق تعرية وإفاضة سردية صورية، وألمًا أيضًا.
فكرة السجن ليست عقوبة بذاتها، إنما السجن- المكان بالتوصيفات المذكورة والتي ستأتي هي العقوبة.
(2)
نوافذ السجن صغيرة وقريبة من السقف خشية هرب السجناء المحكومين مؤبدًا. هذا تبرير رسمي وربما هو قانوني، قد يكون مُرضيًا أو قد يكون فجًّا. إذ ليس بالضرورة أن تكون في قفص السجن طيور جارحة ومفترسات مخيفة وكائنات غير منظورة. إنه فضاء مختلط في المحكوميات والجرائم، يكاد يكون مغلقًا من الجوانب كلها. لا يتنفس كثيرًا، كونه معلّقًا مع القدر الموصوف بأنه قانون المكان. هو مَحْبس ليس فيه شهيق وزفير مألوف، بل اخترع السجناء نظامًا تنفسيًا بالأوراق العادية، حينما تُطوى كأقماع مخروطية، يكون بوزها خارج المبنى من فتحات سرية حُفِرت بالأظافر والدبابيس المهرّبة لتستعيد الهواء النقي من الخارج. وخلاف ذلك، فإنه سحابة مشتركة من أنفاس السجناء، تشير إلى العزلة والوحدة المخيفة عبر مساحة نفسية تكاد تكون واحدة. ولكن ربما تكون النوافذ العليا القريبة من السقف مرايا للهواء النقي. كونها الحرية الوحيدة الصغيرة التي للأنفاس وتجلب أصوات الخارج وخيالها الواسع.
هذا يذكّرنا بقصة “صحراء التتار” للإيطالي دينو بوتزاتي، حيث العزلة في قلعة بعيدة، لا تُرى الحياة من خلالها بشكل واضح. وتذكّرني بقصة على هذا المنوال (لعلها لبوتزاتي ذاته) تقص حياة سجين يعتلي السرير العلوي في العنبر بسبب وفاة السجين الذي قبله، قريبًا من النافذة الصغيرة العليا- قريبا من السقف، ولأنه الوحيد الذي يرى من النافذة ما لا يراه رفاقه في العنبر، يروي لرفاقه السجناء ما يراه من جمال ونساء وأشجار وأنهار وحياة تمر أمام عينيه، وعندما يموت ذلك السجين، يعتلي المكان الرفيق الذي بعده، وكله أمل بأن يرى ما كان يرويه زميله المتوفى، لكنه لم يجد غير الصحراء والرمال والعزلة الموحشة والفراغ الصافر بكل ما يبعث اليأس. لنكتشف بأن السجين المتوفى كان يبعث الأمل والحياة والخيال بين رفاقه السجناء بطريقته الفريدة. كان محبًا للحياة أكثر ممن سبقوه، لذلك انشطر فيه الخيال إلى مديات أبعد من واقع العنبر المغلق، فأدخل بخيال استثنائي جمال الحياة في الخارج إلى رؤوس رفاقه بطريقة سحرية غريبة جدًا، عبر النافذة العليا التي تستجيب لخياله الناشط، وهو يمثل فرحًا مكبوتًا ورغباتٍ محبوسة. وهذا يعني بأن “الفضاء النصي في الرواية والقصة يمكن أن يكون متخيلًا بالرغم من واقعيته…”.
السجن هادم اللذات ومفرّق الجماعات.
(3)
ليس بوسعنا أن نصف السجن على أنه مكان إصلاحي؛ والهدف المطلوب منه هكذا؛ غير أن نضع له وصفًا عامًا على أنه جرثومة بحجم دولة (جرثومة القوانين الوضعية) تتحرك على وفق مبدأ “العدالة” المقوننة التي تضع مواطنيها السجناء تحت طائلتها. لكن تلك الجرثومة المخيفة، تستقطب؛ كالمغناطيس؛ على مدار الفصول أرواحًا ونفوسًا وأجسادًا غضة، حتى خارج نمطية القانون في بعض الأماكن (صيدنايا في سورية- أبو غريب في بغداد… مثالان) لذلك فمثل هذه الأمكنة لن تكون هامشية تمامًا، بل هي في مركزية الدول بشقيها الشمولي والبرلماني. ومركزيتها الباطنية هي حماية النظام السياسي، من المعارضة المسلحة مثلًا، أما من ظاهر تلك المركزية هو الحد من شيوع الاجرام والممنوعات كالمخدرات على سبيل التوضيح. وهذا الالتباس المكاني كالأنشوطة الغليظة؛ مشرعة أمام سكنى العنابر المتداخلة بالجرائم والممنوعات والتجاوزات.
السجن أنشوطة. تذهب يمينًا وتذهب شمالًا.
(4)
يمكن أن نصف السجن على أنه رحمٌ مريض ليس نظيفًا تمامًا، فهو رحم ملتبس في أحشائه. خارج منظومة القياسات المبدئية المجتمعية، فالسياسات تُنشئ خطابًا متوحشًا يكاد يكون موحدًا للسجون. وذلك الخطاب يشير إلى الجسد. وهذا يشير إلى الروح المعنوية الباطنية للسجين، لذلك فالجسد هو المستهدف في الحبس قبل أن تكون الروح العالقة به. الجسد التام الذي عليه أن يخضع لاختبارات مضنية في البقاء في هذا المكان الضيّق سنواتٍ طويلة ليست هيّنة في حسابات الحياة العالقة بين الحياة والموت. ومثل هذا الرحم المريض لن يكون مكانًا للإصلاح في أقل تقدير وتأويل. بل تنمو فيه أمراض محسوسة وغير محسوسة، تتجسم واضحة في الصراع بين البقاء القسري في قانونية السجون. وما دامت السياسات تُنشئ خطابها بهذه الصورة، فإن المجتمعات بدورها تنشئ خطابًا مضادًّا، لكنه مشتت كخطاب يطالب بالحرية ضد القانون الوضعي الذي وضعته تلك السياسات. مدركة أن الرحم المريض ينشر عاهاته على المسجونين، لا سيما من ذوي الأحكام الطويلة.
وفي هذا التضاد الأولي والنهائي، يحتدم صراع لا يبدو ظاهرًا على المسرح الشعبي العام، لكنه يظهر على المسرح الحكومي بشكل من الأشكال. فالزيارات الشهرية للسجون هي خطاب نوعي، يفسّر مظلومية السجناء ويدعو بصمت متكرر إلى التسامح، ويقترح حلولًا أخرى غير عُلب السجن وعنابره المريضة المصابة بأكثر من داء. لكن الدول بصورة عامة لا تلتفت إلى الأغلبية الصامتة، ولا تجد بديلًا غير السجن لحبس الناس فيه.
كل رحمٍ فاسد هو من سلطةٍ فاسدة.
(5)
أمراض السجن هي أمراض الحرية المستبعدة خارج أسواره واسمنته الثقيل. الانعكاس هنا بأن تصبح الحرية المفقودة هي المرض الذي يناغيه السجناء مهما كانت سنوات أحكامهم. والحر هو “إنسان سعيد” بتعبير ملخّص من اليوناني ثوسيديديس. والسجن بمفهومه الأوسع، جزء خطير من لعبة الحرية التي يتوجب استعادتها بالصبر والنسيان؛ كما يقول أحد السجناء في تحقيق استقصائي قديم، وهي حكمة بالغة ذات يأس مبرمج على مضي سنوات غير قليلة. وربما هذا يدلنا على أن السجن ليس فراغًا بالمعنى الحصري، إنما هو فضاء متخم بالحيوات المتحركة والأنفاس المجروحة. ولنا أن نقول بأنه شيخوخة مبكرة فُرضت على المجرمين والأبرياء على حد سواء. هو ساحة للتشريط الجسدي البطيء. عقاب نفسي ليس مبرمجًا على نحو متكامل. بل يصفه ميشيل فوكو بالعقاب الجسدي. لذلك فالسجون كلها تنتمي إلى وحشية السجانين في الدول الديكتاتورية ذات الأنظمة الشمولية. فالعقوبات التي تقع على السجناء، بالرغم من الأذى النفسي فيها، فإنها أذى جسدي.
السجن يعيد صياغة الأجساد البشرية على النحو الذي يرتأيه، حتى لو تقاطع مع المفهوم الاجتماعي وأخلاقياته وبيئته. لنجد بأن السجن؛ كعقوبة؛ لا يعتقل السجين بوصفه بشرًا خطّاءً. إنما يعتقل جسده قبل هذا، تحت أوامر عُليا وبنود قد تكون مفاجئة للسجناء، منها إذلال الجسد بالعمل الشاق، أو الضرب غير القانوني. أو الحط من قيمته الأخلاقية. لذلك نقرأ عن اضرابات السجناء في السجون تحت هذه الطائلة القاسية. فالسجين جسد قبل أن يكون روحًا وموهبةً ووظيفة وخطًا؛ مقصودًا أم غير مقصود. وبالتالي فهو كيان اجتماعي ضمن جماعة اجتماعية لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف. وعليه فإن فهمنا لسلوك السجن اليومي من أنه مكان تابع، غير مستقل، ذيل للسلطة بتابعية إدارية إلى وزارة معنية، والسجانون عبارة عن وظائف رسمية، تكبر وتصغر ليس بالوظيفة فحسب، إنما بالقسوة في كثير من الأحيان، وبابتكار وسائل عقابية تالية تضاف إلى العقوبة الأكبر وهي الحبس المشدد. وتلك هي اجتهادات تبرر إساءة السجين للسجن، لنفسه، وللآخرين. وهنا تتوضح ازدواجية السجان السايكوباثية العدائية الاضطرابية؛ فما لم يتحقق له خارج السجن، يمكن تحقيقه بسهولة داخل السجن، فالسجناء عراة، أبرياء، معزولون، أسرى، أذلّاء، عُزّل، قاصرون، وأطفال بالضبط.
الجسد البشري هويتنا الإنسانية التي نحملها في الظروف كلها.
(6)
السجين لا يملك لغة. فقد لغته أثناء دخوله إلى هذا المكان. وتحول إلى كائن يتلقى الأوامر ولا ينطق. فـ “المكان يحدد هوية المتكلم” بحسب تعبير الناقد ياسين النصيّر. ولما تكون الهوية مفرّغة من محتواها الأساسي، تصبح لا قيمة لها في المكان، وتصبح اللغة عاجزة عن الوصول إلى اللغة، لذلك يبتكر السجناء طرقًا كثيرة في التواصل البصري والنفسي. كإيجاد مفردات بعينها داخل العنبر المغلق. تخص الطعام والنوم وقضاء الحاجات او التمرد او الهرب أو الكتابة على جدران السجن بما يشي بالحالة النفسية للسجين؛ من كلمات مؤلمة إلى الأمهات والآباء والزوجات والأبناء والحبيبات.
ومن ثم الحرية التي صارت بعيدة، بعد أن كانت بقبضة اليد. لهذا نتوصل إلى أن السجن يُعد من الأمكنة غير السوية في الحياة، مكان معادٍ، شرس، قذر، ذو وظائف مزاجية في كثير من الأحيان. طاقة سلبية بشحنات كهربائية مُعكّرة للجسد والروح والنفس والمزاج. نستطيع القول بأنه من أحط الأمكنة التي تعادي الإنسان في حياته، فالجريمة الشخصية لا تبرر جريمة المكان المغلق على جمال الإنسان مهما كان خطؤه وخطيئته. وإيجاد العقاب لا يتناسب مع كون السجين انسانًا له شروط البقاء في الحياة واستشراف جمالياتها الكثيرة، لذلك نجد أن الأفق النفسي عند السجين هو أفق عمودي يترامى ويلتصق بالسماء، كونها منقذاَ أخيرًا، ومغفرةً عظيمة، حتى نجد بالتمعن الدقيق لمثل تلك الظروف الموحشة في العنابر بأن تركيب السجين هو تركيب ذو طبقتين، عليا وسفلى. كلاهما يرتجي الحرية بأمل الانعتاق، كون السجن لوحة سوداء كبيرة رسمها سجناء مختلفون، سابقون ولاحقون. وسيُكملها مستقبليون لم يرتدعوا من أسلافهم السجناء. تلك اللوحة الفظيعة الرسْمية التي تقاطعها حروف الرجاء إلى السماء تشير إلى أن آلاف السجناء غير المحظوظين في الحياة أمضوا عليها ووقعوا أسماءهم تحتها. كإشارات عاطفية إلى المستقبل المظلم.
مستقبل السجن لوحة سوداء مر عليها رسامون كثيرون.
(7)
المسافة بين سجينين هي المسافة بين سجنين. لا بحسب التصميم الهندسي للسجن. لكن لكل سجين سجنه، وتهمته، وخطؤه، وتجاوزه على القانون. وفي مطالعات سريعة لسجون العالم الشهيرة وغير الشهيرة، سنجد تصاميم متشابهة للعذاب البشري وإن اختلفت من مكان إلى آخر، لكنها تتشابه في كونها علبة تحشر السجناء حشرًا حتى لو توسعت قاعاتها وعنابرها. فيكفي أن زحام الأنفاس فيها يُضفي كراهة ومقتًا في المكان. وتلاصق الأجساد يعني فيما يعنيه، إيذاءها وعدم احترامها، فالتلاصق هو حشر بذيء، مقصود لإذلال الجسد وانتهاكه، والرسْم عليه بمعطيات أخرى، يُراد منها أن تنصهر اجتماعيًا لاحقًا. حتى الأفرشة المليئة بالحشرات الناعمة والقمل والبعوض، تؤكد امتهان الجسد وتقويض فاعليته النفسية، وإضعاف طاقته الإيجابية وترسيخ الطاقة السلبية كونها عقابًا إضافيًا لا مفر منها في الظروف المشددة.
إنّ نظرة سريعة على هذه الأمكنة السلبية، لا تجد فيها نوافذ صحية. النوافذ عالية في الغالب. بما يشير إلى أن التحكم في الهواء هو من معايير المكان. ولأنها تنقل أصوات الخارج وروائح الحرية فيه فلا بد من حجبها نسبيًا. لا يريدون تذكير السجناء بالماضي السعيد ولا الحرية التي كانت متاحة. حتى ملابس السجناء متشابهة في الأغلب الأعم. عدا اللون الأحمر فهو للمحكومين بالإعدام، وهؤلاء لهم عنابر خاصة لا يختلطون بسجناء الجرائم الصغيرة والكبيرة. وقلما يراهم أحد سوى المكلفين بحراستهم الموضعية.
ملابس السجين الموحّدة نصف هزيمته.
هوامش ومراجع:
مجلة العمدة وتحليل الخطاب- المجلد 7 العدد 01 – 2023
المكان الروائي – ياسين النصير- دار نشر أهوار. بغداد – 2024
دينو بوتزاتي صحافي وأديب وشاعر وكاتب مسرحي وناقد فني ورسّام وعازف بيانو وكمان إيطالي. أشهر رواياته “صحراء التتار” التي تحولت إلى فيلم من إخراج فاليريو زورليني.
رواية “شرق المتوسط” لعبد الرحمن منيف من الاتجاه الواصف لوحشية السجن في تدمير الجسد وإيذائه. و”تلك الرائحة” لصنع الله ابراهيم تنحو في هذا المنحى. وتبقى رواية “السجينة” للمغربية مليكة أوفقير فريدة في مأساتها الشخصية، وهي ابنة الجنرال محمد أوفقير، وزير الداخلية والدفاع، وثاني شخصية قوية بعد الملك الحسن الثاني، فتوثق ببراعة وألم نادر ما تعرضت له وأسرتها من تعذيب نفسي في سجن صحراوي سري في الصحراء الكبرى، بعد الانقلاب الفاشل الذي قاده والدها الجنرال مما تسبب في إعدامه. وعندما نذكر شواهد قليلة عن السجون الروائية العربية، فمن اليقين والأكيد لا ننسى السجون الإسرائيلية المغلقة على السجناء والأسرى الفلسطينيين من رجال ونساء وصبيان وأطفال. والأدب الفلسطيني يقتفي أثر تلك المرارات الباحثة عن الحرية في مشواره المقاوِم الطويل. وقد نعرف أو لا نعرف بأن كثيرًا من الروايات الفلسطينية هُرّبت مخطوطة بشكلٍ أو بآخر خارج أسوار السجون الإسرائيلية. وكثير من الروايات تحدثت عن تلك السجون الخطيرة مثل: “حكاية صابر” لمحمد عيسى و”مهندس على الطريق” لعبدالله غالب البرغوثي و”ستائر العتمة” لوليد الهودلي. ولا بد من الإشارة إلى أن رواية السجين الفلسطيني باسم خندقجي “قناع بلون السماء” فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية “بوكر” في دورتها السابعة، أي خرجت من السجن إلى الفوز.
إذا ما تركنا الروايات التي يتفاعل معها الخيال ويفعّل نسيجها الشخصي الداخلي، حتى لتبدو أشبه بالصورة التي تكثر التواريخ عليها، فالضرورة تقتضي الإشارة إلى سجنين عربيين غير عاديين؛ ظهر الأول منهما قبل عقدين من الزمان وهو سجن أبو غريب في بغداد، والآخر كُشف في سورية قبل بضعة شهر، وهو سجن صيدنايا المرعب.
ميشيل فوكو: مفكر وفيلسوف فرنسي. من أهم المفكرين الغربيين في النصف الثاني من القرن العشرين، كما يوصف بأنه الفيلسوف الأكثر تأثيرا في فلاسفة ما بعد الحداثة.
ثوسيديديس: مؤرخ يوناني قديم ومؤلف كتاب “تاريخ حرب البيلوبونيز” الذي يشرح تفاصيل الصراع في القرن الخامس بين أثينا واسبارطة. كان عمله أول تسجيل تاريخ باستخدام أساليب “حديثة”، وأول تحليل أخلاقي وسياسي لسياسات الحرب في البلد.
ويكيبيديا – الموسوعة الحرة.




