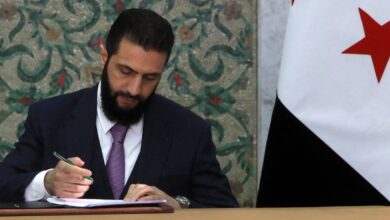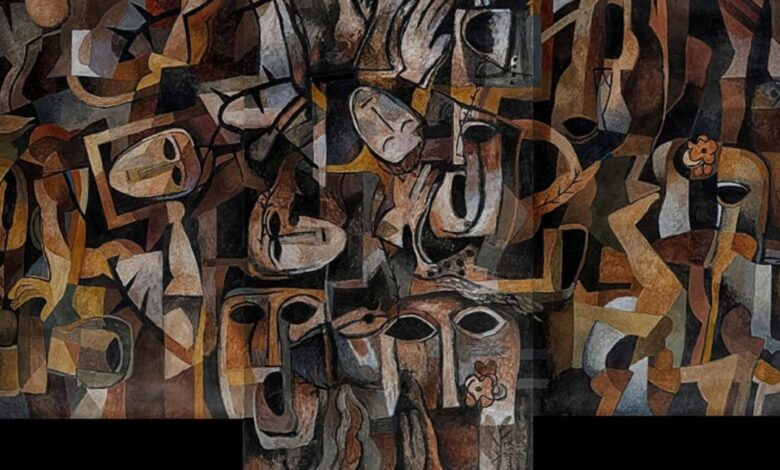
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
———————————-
السلفية الشامية: آفاق وإمكانات؟/ محمد أمير ناشر النعم
17 مارس 2025
تخوّف بعض السوريين من الاتجاه السلفي، ولا سيما الجهادي، الذي سيطر على كثير من المتدينين في سوريا، خصوصًا في المناطق المحررة قبل سقوط الأسد. وقد كان لهذا الاتجاه جاذبيته؛ إذ أسهم في صياغة هوية صلبة تتيح للمنتمين إليه مقاومة السلطة الأسدية مادّيًا من جهة، ومقاومة التغلغل الشمولي للدولة الحديثة من جهة أخرى، حيث باتت الدولة لدى بعضهم مرادفة للسلطة الأسدية، في حين رأى آخرون فيها التزامًا بها. وقد تجلّت هذه المقاومة الثقافية في اللافتات الطرقية التي انتشرت في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة ذات الطابع السلفي، والتي نصّت على أن الديمقراطية تارةً تُعدّ شركًا، وتارةً أخرى تُوصَف بأنها طريق إلى التخلف، وفي أحيان أخرى تُسمّى صنم العصر.
ويتخوّفون اليوم أكثر بعد سقوط السلطة الأسدية، وتدفّق الجماعات الإسلامية الجهادية من إدلب إلى جميع أرجاء سوريا.
بالنسبة إليّ، فإنني لا أتخوّف من هذه الاندفاعة للأسباب التالية:
أولاً: فيما يخص السلفية الجهادية، فنحن أمام حالة رفض مجتمعي لها؛ إذ يُنظر إليها على أنها حلٌّ بائس ويائس لتجاوز الواقع. وقد أطلقت الدولة الإسلامية في العراق والشام رصاصة الرحمة على هذا النموذج القتالي، مما أدى إلى انغلاق مساره بوصفه نموذجاً جاذباً للسلفية الجهادية.
ثانياً: إن المعقل الأساسي للسلفية في السعودية يشهد تحوّلات هائلة ندرك جميعاً أبعادها ومضامينها. ومن أهم هذه التحولات انكفاء السعودية عن دعم هذا الاتجاه وتمويله في البلدان الأخرى، مما سينعكس على جميع التيارات السلفية ويدفعها إلى إعادة النظر في كثير من أفكارها وممارساتها. بالطبع، هذا لا يمنع استمرار وجود بعض جيوب الدعم من مؤسسات خاصة، وقد رأينا آثارها في افتتاح بعض المكتبات في الشمال السوري التي توزّع المطبوعات والكتيّبات السلفية مجاناً.
ثالثاً: إن الأداء الذي توصف به هيئة تحرير الشام بالبراغماتية لا يمكن تفسيره بالبراغماتية وحدها؛ فمن جانب آخر، لا يمكن إنكار أن كثيراً من الأفكار والتصورات تتشذّب وتتهذّب حين تمرّ عبر مبرد الممارسة العملية، وتعبر الجسر من النظرية إلى التطبيق. ونحن هنا، وإن كنّا ندرك مشكلة التفاوت في تقبّل هذا التحوّل لدى أتباع هيئة تحرير الشام، بسبب اختلاف رؤاهم الدينية وفهومهم لطبيعة الدولة المأمولة، فإننا نعي في الوقت ذاته أنها لا تضمّ أجنحةً متنافسة. إننا أمام تحوّلات فكرية شاملة داخل الجماعة، ويبدو أن قائد الهيئة يُحكم قبضته على خيوط اللعبة داخل تنظيمه بقوة واستمرار، مما يجعل الانقلاب عليه في المدى المنظور غير وارد.
وبناءً على ذلك، فإن على هيئة تحرير الشام خصوصاً، وعلى السوريين عموماً، إعادة اكتشاف السلفية الشامية، والتي يمكن تسميتها بـ”السلفية الشامية الإصلاحية”؛ إذ كانت أساس نهضة بلاد الشام على مختلف الأصعدة؛ وذلك في مقابل السلفيات المعاصرة التي يُتداول الحديث عنها اليوم. لقد تميّزت السلفية الشامية بمبادرتها إلى الانفتاح على العلوم غير الدينية، وعلى الصحافة والإعلام، وكان روّادها أول من مدّ الجسور إلى الشخصيات السورية التي لا تنتمي إلى طبقة العلماء، كما كانوا السبّاقين إلى تفكيك الطابع النخبوي الصارم لهذه الطبقة.
إن إعادة هذا اكتشاف يسهم في تسهيل مهمة القائمين على إدارة دفة الدولة في سوريا اليوم، ويحدّ من غلواء الاتجاه اليميني في صفوفهم.
ويأتي على رأس هؤلاء العلماء الشوام الشيخ عبد الرزاق البيطار (1837–1916)، والشيخ محمد الشطي (1832–1890)، وأحمد الجزائري (1833–1902)، وهو أخو الأمير عبد القادر الجزائري، والشيخ بكري العطار (1834–1903)، والشيخ طاهر الجزائري (1852–1920)، والشيخ عبد الفتاح الإمام الدمشقي (1870–1963 أو 1964)، والعلامة جمال الدين القاسمي (1866–1914)، وسليم البخاري (1884–1928)، ومحمد بهجة البيطار (1894–1976)، وأحمد مظهر العظمة (1909–1982)، وعلي الطنطاوي (1909–1999)، ومحمود مهدي الإستانبولي (1909–1998)، ومحمد ناصر الدين الألباني (1914–1999)، ومحمد زهري النجار (1920–؟)، وجودت سعيد (1931–2022)، وخير الدين وانلي (1933–2004)، والشيخ محمد بهجت البيطار.
وقد امتازت سلفية الشيخ القاسمي على سبيل المثال، بما أجمله الأستاذ حسان القالش في كتابه (سياسة علماء دمشق) في النقاط الأربع التالية:
1 ــ الرفض القاطع للتكفير.
2 ــ محاولة بناء الجسور بين السنة والشيعة والتخفيف من الخلاف بينهما.
3 ــ رفض تكفير ابن تيمية لابن عربي، وتصنيفه ضمن الفلاسفة كالفارابي وابن رشد.
4 ــ مخالفة القاسمي ابن تيمية في الهجوم على المنطق والفلسفة([1]).
وأضيف إلى ذلك:
5 ــ عدم معاندة العلم واكتشافاته وعدم استخدام النصوص الدينية لتأييد هذه المعاندة.
6 ــ الانفتاح الحقيقي على المخترعات العصرية وعدم رفضها رفضاً مبدئيًّا أو التوجس منها، أو محاولة تجاهلها وكأنها غير موجودة.
7 ــ إقامة شراكات مع أبناء الطوائف الأخرى على مبدأ المواطنة.
وإذا تابعنا أداء السلفيين الإصلاحيين بعد القاسمي، أمثال الشيخ محمد بهجت البيطار، وأحمد مظهر العظمة، ومحب الدين الخطيب، ومحمود مهدي الإستانبولي وغيرهم، فسنجد أن ممارساتهم تميّزت بما يلي:
1 ــ الاعتراف بالدولة الوطنية الحديثة والمشاركة في مؤسساتها.
2 ــ المشاركة السياسية بالانخراط بالأحزاب والانتخابات البرلمانية.
3 ــ دعم المرأة وإيصال صوتها أدبياً على أقل تقدير.
4 ــ السمة النقدية لواقع الإسلام والمسلمين والدعوة المتكررة إلى الإصلاح.
5 ــ رفض الطائفية رفضاً قاطعاً. (رفض قانون الطوائف الفرنسي).
فروقات بين السلفية الشامية والسلفية النجدية:
لعلّ أهم فرق بينهما هو أن السلفية الشامية كانت تتقبّل التعددية بجميع تجلياتها، وتتحلّى بقدر من التسامح، خلافاً للسلفية النجدية. ومن هذا الفرق تحديداً، يمكن أن تتفرّع جميع الفروق الأخرى.
نجد في السلفية النجدية كتاب “كتب حذّر العلماء منها”، تصنيف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وتقديم الشيخ بكر عبد الله أبو زيد، الذي يُعدّ من أبرز علماء الاتجاه السلفي النجدي المعاصرين.
يعبّر هذا الكتاب عن منهج السلفية النجدية في التعامل مع الكتب التي تراها مخالفة لفهمها أو رؤيتها، بل حتى لمزاجها. ففي جزئه الأول فقط، يتناول المؤلف أكثر من 400 كتاب، يراها مناوئة أو مقلقة، فيحذّر منها مبيّناً فسادها وانحرافها. وتشمل هذه الكتب رسائل إخوان الصفا، وبعض رسائل الجاحظ وأبي حيان التوحيدي، وكتباً لداود بن خلف الأصبهاني، وأبي القاسم البلخي، والبيروني، والمجريطي، والسيوطي، وغيرهم.([2])
إننا هنا أمام بوليس المعنى الواحد المرضي عنه، الذي يتتبع كل معنى مغاير فيزجّ به في قفص الاتهام!
هل يمكن مقارنة هذا التوجه بصنيع محب الدين الخطيب الذي أسس، مع صاحبه عبد الفتاح قتلان([3])، المطبعة السلفية في القاهرة، فغدت من أهم منابر الاتجاه السلفي؟ ولكن عندما نتتبع عناوين إصداراتها، ندرك بحق ما نعنيه بالسلفية الشامية، وما تتميّز به من مرونة واستيعاب للآخر المختلف، وانفتاح عليه وتفاعل معه. ولذلك، لن نتفاجأ حين نرى هذه المطبعة تطبع ترجمات لغوستاف لوبون، وغليوم الثاني، ورينيه ديكارت، وإيمانويل كانط، وبول بورجيه، أو تطبع كتب الفلسفة مثل كتاب مبادئ الفلسفة القديمة الذي جمع بين دفتيه كتابين لأبي نصر الفارابي، الأول: ما ينبغي أن يُقدّم قبل تعلّم فلسفة أرسطو.
والثاني: عيون المسائل في المنطق ومبادئ الفلسفة. كما تطبع مسند الإمام الربيع بن حبيب الأزدي، وهو من مصادر المذهب الإباضي المعتمدة، أو تطبع الرسائل المتبادلة بين أبي العلاء المعري وداعي الدعاة الفاطمي أبي نصر بن أبي عمران. كما تطبع رسالة الملائكة للمعري، وكذلك أبو العلاء المعري وما إليه لعبد العزيز الميمني الراجكوتي. وتطبع أيضاً للأدباء العرب على اختلاف صنوفهم، مثل مصطفى صادق الرافعي، أو أحمد زكي أبو شادي، أحد مؤسسي مدرسة أبولو الشعرية.
ويمكن أن نتلمس هذه السلفية الشامية كذلك، في تجربة الأستاذ أحمد مظهر العظمة ورفقائه الذين حملوا معه عبء إنشاء جمعية التمدن الإسلامي سنة 1932 (محمد حمدي السفرجلاني، عبد الفتاح الإمام، عبد الرحمن الخاني، عبد الحكيم المنير، وأحمد حلمي العلاف). كان لهذه الجمعية نشاط ثقافي واجتماعي خدمي، فأصدرت مجلة التمدن الإسلامي سنة 1935، وأسست مدرسة سنة 1945، ومستوصفاً خيرياً سنة 1959. كما كانت الجمعية منفتحة على جميع الأديان والمذاهب، فاستعانت في المدرسة بأساتذة مسيحيين، وفي المستوصف بطبيب مسيحي، وافتتحت فرعاً لها في قرية بيت الشيخ يونس في مصياف سعياً للتواصل مع العلويين.
وتعكس مجلة التمدن الإسلامي روح هؤلاء السلفيين بشكل أوضح وأجلى؛ فمؤسسوها سلفيون تقليديون دينيًّا وعقديًّا، وإصلاحيون ديمقراطيون فكريًّا وسياسيًّا، يؤمنون بالتعددية الفكرية والسياسية، ونرى ذلك واضحاً في كتاباتهم، وفي استعراض أسماء الكتّاب الذين نشروا لهم في المجلة، حيث نجد فيها سلفيين كمحمد ناصر الدين الألباني الذي نشر في المجلة 155 مقالاً، ومحمود مهدي الإستانبولي الذي نشر 406 مقالاً، ومحب الدين الخطيب وعلي الطنطاوي، ومحمد نسيب الرفاعي، وعبد الفتاح الإمام، وعبد العزيز بن باز، وعبد الرحمن الدوسري، وسواهم، ونجد فيها صوفيين وأشاعرة كعبد الله الصديق الغماري، ومحمد سعيد رمضان البوطي، وعبد الفتاح أبو غدة، وأحمد عز الدين البيانوني، ومحمد أبو اليسر عابدين، وصالح الفرفور، وعبد الغني الدقر، وكذلك قادة الإخوان المسلمين كحسن البنا، وسيد قطب، ومحمد قطب، ومصطفى السباعي، ومحمد الحسناوي، وعصام العطار، وأنور الجندي، ومحمد المبارك. هذا بالإضافة إلى شخصيات مسيحية كإميل الغوري، وإميل جبر ضومط، وجورج شدياق، وحليم دموس، ونظمي لوقا وشبلي ملاط، وخليل جرجس خليل، ونيكولا حنا، وميخائيل عواد، وشخصيات نسائية كألفة الإدلبي وألفة الصواف، ومي نخلة، ونزهة العظمة، ونديدة العقاد عابدين، وشخصيات شيعية كمحمد الخالصي، ومحمد جواد مغنية، ومحمد رضا الشبيبي، وأحمد الصافي النجفي، ومحسن الأمين، وتعرّفه المجلة بقولها: سماحة العلامة الأستاذ الشيخ السيد محسن الأمين.
في السلفية الشامية، نرى كيف يتحول الفكر السلفي إلى واقع اجتماعي، فإذا هو فكر يتجاوز الأطر الضيقة التي رسمتها السلفية النجدية لنفسها. فها هو أحمد مظهر العظمة يرشّح نفسه لانتخابات عام 1947 البرلمانية ضمن قائمة الأمة، التي ضمّت شخصيات مسيحية ويهودية، وحازت تلك القائمة يومها على تأييد علماء الدين في مدينة دمشق.
ويمكننا هنا أيضاً أن نشير إلى تجارب سلفية انطلقت في اجتهادها إلى آفاق بعيدة، مثل تجربة الشيخ جودت سعيد الذي بدأ مسيرته الفكرية متأثراً بالسلفية. لكن تلك الروح السلفية التي امتاز بها لم تلبث أن تتكشف عن تطوّر يفرّق بينه وبين رموز هذا التيار، دون قطيعة أو موقف متشنّج. وسوف تثبت مسيرته المستقبلية أنه تحلّى بالجانب الإيجابي من السلفية في كونها دعوة للاجتهاد، وأنه تخلّى عن الجانب السلبي منها في كونه يرى في الماضي مثالاً يجب تقليده بلا نقد أو تمحيص. ولذلك، سنراه فيما بعد لا يقتصر على إعمال العقل والفكر في أقوال السلف والخلف فحسب، بل في مواقفهم أيضاً.
لقد كانت سلفيته مشرَّبة بالمرونة والانفتاح الذهني والوداعة التي لا تعرف تسرّع الحنق الفقهي ولا احتدام الغيظ العقدي. ولعل صحبته للشيخ محمد زهري النجار أكسبته تلك المرونة والانفتاح، فعلى الرغم من نزعة الشيخ زهري السلفية، فإنه لم يفقد جسور التواصل مع أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، حتى تلك التي تُوصف عادةً بالانحراف. ويحدثنا السيد مرتضى الرضوي عن لقائه بالشيخ محمد زهري في القاهرة سنة 1950، ومناقشته إياه في مفهوم التقيّة ومواردها، ويصفه قائلاً: “وجدته يتحلّى بالمرونة والسماحة واتباع الحق، وله جهود وجهاد في سبيل تدعيم وحدة صفوف المسلمين في مواجهة أعدائهم”([4]).
خلاصة:
إنّ ما عرضناه في هذا النص هو تكثيف شديد لبحر متلاطم من شخصيات عديدة تتوافق في كثير من النقاط التي أشرنا إليها بوصفها تجسيداً للسلفية الشامية، وتختلف في نقاط أخرى. وقد يندّ بعضها في موقف أو أكثر عن السياق العام الذي نحاول أن نثبته ونؤكده، كما تندّ موجة من موجات البحر، ولكن ذلك لا يؤثر على هذا السياق بالنقض.
سياق قبول التعدد بوصفه أحد مكونات الوجود: قبول التعدد الحضاري، وقبول تعددية المواقف والتقييمات، وقبول تعددية الخطاب وتعددية المعنى بجوانبها الحسنة والسيئة التي تُراقب وتُروّض، ولكن لا تُنفى ولا تُقتلع. فهذا ما لا ينبغي، بل ما لا يمكن.
[1] حسان القالش، سياسة علماء دمشق: أسئلة الإصلاح والهوية والعروبة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2024، ط 1، ص 234
[2] انظر: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، كتب حذّر العلماء منها، تقديم بكر عبد الله أبو زيد، دار الصميعي، الرياض، ط 1، 1995
[3] عبد الفتاح قتلان شخصية دمشقية مغمورة تستحق أن تُدرس. ويُقال: قتلان نسبة إلى مقاطعة كاتالونيا في الأندلس، وأن أجداد الأسرة هاجروا منها بعد سقوطها إلى دمشق.
هاجر عبد الفتاح إلى مصر، وشارك محب الدين الخطيب الذي تربطه به صلة قرابة افتتاح المطبعة السلفية. وألّف بعض الكتب كفهرست المؤلفين بالظاهرية وشواهد لسان العرب مرتبة على حروف المعجم. نشاهد اسمه على مطبوعات المكتبة السلفية جنباً إلى جنب مع محب الدين الخطيب، ولكن بعد وفاته مباشرة تصبح مطبوعات الدار باسم محب الدين الخطيب فقط. استقلّ عبد الفتاح بتأسيس مطبعة سلفية أخرى في السعودية سنة 1928 أو 1929 مع الصحفي والسياسي السعودي محمد صالح نصيف وشركاء آخرين غير مذكورين، توفي سنة 1933، وربما لو عاش كما عاش محب الدين حتى سنة 1969 لكان ذكره وحضوره مختلفين.
[4] انظر: سيد مرتضى الرضوي، مع رجال الفكر في القاهرة، ط 1، (بيروت ــ لندن، الإرشاد للطباعة والنشر، 1998)، ص 330
مؤسسة مؤمنون بلا حدود
———————————
هندسة الطاعة في سوريا.. السلطة بوصفها مشروعاً لإعادة تشكيل الذات/ مالك الحافظ
مارس 31, 2025
في أعقاب الانهيار الرسمي لنظام بشار الأسد، برزت ما تُعرف اليوم بـ”السلطة الانتقالية” كإطار بديل عن السلطة المركزية الاستبدادية التي هيمنت على البلاد لعقود. غير أن هذه السلطة الناشئة، عوض أن تكون تجسيداً لتحول سياسي جذري يعيد بناء العلاقة بين الحاكم والمحكوم، راحت تمارس سلطتها عبر آليات جديدة تستند إلى خطاب ديني سلفي وتأويلي، يُعيد إنتاج الطاعة من داخل المجتمع لا عبر القسر المباشر. نحن هنا أمام لحظة انتقال من السلطة بوصفها احتكاراً للعنف، إلى السلطة بوصفها هندسة للطاعة.
في تحليله للسلطة الحديثة، يبيّن ميشيل فوكو أن السلطة في المجتمعات المعاصرة لا تعمل فقط بالقمع، بل تنتج ذاتاً خاضعة من خلال آليات المراقبة والتطبيع والانضباط. ويقول إن السلطة ليست ما يُؤخذ أو يُمنح، بل هي شبكة من العلاقات تُنتج المعرفة، وتُعيد تشكيل الأجساد والوعي.
بهذا المعنى، يمكن فهم ما يحدث في الحالة السورية على أنه إعادة صياغة للذات السياسية والاجتماعية للمواطن، حيث لا يُطلب من الأفراد المشاركة، بل الخضوع؛ لا يُساءَل الحاكم، بل يُمجد؛ ولا يُناقش العقد الاجتماعي، بل يُلغى لمصلحة خطاب مطلق حول “الثوابت” و”المنهج”.
في المقابل، يطرح أكسيل هونيث مفهوم “الاعتراف” بوصفه أساساً للعدالة الاجتماعية، حيث تُقاس شرعية الدولة بقدرتها على الاعتراف المتبادل بين الأفراد كذوات مستقلة ومتساوية. وهو ما يغيب عن السلطة الانتقالية السورية كلياً، إذ تُنكر أصلاً شرعية الفرد المختلف، وتُعيد إنتاجه ككائن ناقص، غير مكتمل، يحتاج إلى التهذيب والإرشاد.
تنطلق السلطة الانتقالية في سوريا من بنية أيديولوجية سلفية لا ترى المجتمع ككلّ متعدّد، بل كمادة قابلة للتطويع وفق مسار تأويلي مغلق. المجتمع ليس شريكاً في الفعل السياسي، بل حقلٌ للدعوة والإصلاح.
ضمن هذه الرؤية، تُعرّف المرأة كـ”موقع أخلاقي هش”، يجب احتواؤه لا تمكينه، ويُفهم التنوّع المذهبي والديني بوصفه تهديداً للنقاء لا تجلياً للتعدد، ويُنظر إلى النقد كفعل تخريب، لا كأداة إنتاج سياسي مشروع. وهكذا، تتحول السلطة إلى منظومة تهذيبية لا مؤسساتية، حيث يصبح القانون امتداداً للفتوى، والمواطنة مرهونة بالسلوك، لا بالحقوق.
لغة السلطة الانتقالية تكشف عن منطقها العميق. فهي لا تتحدث عن “المواطن”، بل عن “الرعية”. لا تعد بـ”الحقوق”، بل بـ”الاستقامة”. لا تعد بـ”التنمية”، بل بـ”التمكين الشرعي”. هذه المفردات، التي قد تبدو عابرة، تعبّر عن تحول جوهري في طبيعة الدولة نفسها. نحن لا نواجه نظاماً سياسياً، بل منظومة تأويلية مغلقة، تدير شؤون الناس بوصفهم ناقصين، قاصرين، يحتاجون إلى الرعاية لا الشراكة.
هذا النوع من الخطاب يتماهى مع ما وصفته حنّه أرندت بأنه “إلغاء السياسة لحساب الحقيقة المطلقة”، حيث لا تعود القوانين ناتجة عن التوافق المجتمعي، بل تُشتق من مرجع أعلى لا يمكن مساءلته. تقول أرندت في كتابها “أصول التوتاليتارية” بأن الخطر الحقيقي لا يكمن في الاستبداد، بل في تحويل الحقيقة إلى مرجع سياسي لا يقبل التفاوض.
السلطة الانتقالية لا تعيد بناء الدولة، بل تعيد إنتاج الطاعة كبنية كلية، فالمدرسة تتحول إلى جهاز تطبيع، والخطاب الديني إلى أداة مراقبة، والمجتمع المدني إلى امتداد دعوي.
كل ما لا ينسجم مع سردية السلطة يُقصى، يُتهم، يُحاصر. لكن ليس باسم الخيانة، بل باسم “الضلال”، و”الفسق”، و”الفتنة”. وهكذا، تتحول السياسة إلى أخلاق، والمشاركة إلى امتثال.
ما يُبنى اليوم في سوريا ليس مشروع انتقال ديمقراطي، بل نظام اجتماعي مغلق يُنتج العطالة بدل المشاركة، والخوف بدل الأمل. إن هندسة الطاعة التي تمارسها هذه السلطة لا تستهدف فقط تقييد الفعل، بل إعادة تشكيل الوعي.
————————————-
حيادية الدولة والهُويَّات المجتمعية/ عبد الباسط سيدا
01 ابريل 2025
العلاقة بين مؤسّستي المعبد والقصر قديمة، تعود بجذورها إلى أيّام الحضارات السالفة التي شهدتها منطقتنا ومناطق أخرى في العالم. وتذكر في هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر، حضارات مصر وبلاد ما بين النهرين والهند والصين وغيرها. وغالباً ما كانت السلطة الفعلية بيد القصر في حين أن وظيفة المعبد كانت تتمثّل في إضفاء الشرعية على سلطة القصر، وتسويقها، وإحاطتها بهالة من القداسة عبر طقوس محدّدة، كانت تُؤدّى في أوقات بعينها، وهي طقوس تحوّلت لاحقاً أعياداً أو مناسبات دينية، غدت مع الوقت عنصراً أساساً من عناصر الثقافة المجتمعية، وبعداً رئيساً من أبعاد تحديد الهُويَّة المكتسبة الخاصّة بهذا المجتمع أوذاك. ولكن على وجه العموم، كان العاهل أو الأمير أو الحاكم في القصر يتمتّع بصلاحيات مطلقة في ما يخصّ أمور إدارة الدولة، في حين أن الكاهن الأكبر كان يتمتع بامتيازات وصلاحيات واسعة ضمن المعبد، شرط ألا يتجاوز حدوده، ويلتزم بما يأمره به الحاكم، بغضّ النظر عن اللقب الذي كان يحمله.
وفي حالات احتدام المنافسة بين المؤسّستين، كان العاهل يُعلن نفسه إلهاً ليقطع الطريق على الكهنة، ويُفشِل مساعيهم من أجل الوصول إلى الحكم أو فرض السلطة على الحاكم. هذا ما حدث، بل تحوّل عرفاً في مصر، كما حدث في بلاد النهرين في عهد الملك الأكدي نارام سين. وفي حالات معيّنة كان العاهل يحرص على وضع ابنته في المعبد لتتحوّل كاهنةً متنفّذةً، تراقب الأوضاع الداخلية في المعبد وتمارس التأثير. وفي حالات معينة كان الكهنة يستغلّون ضعف الحاكم، فينقلبون عليه، ويسطيرون على الحكم، أو يفرضون على العاهل شروطاً تعزّز سلطتهم. ولكن بصورة عامّة كان القصر هو صاحب القرار في شؤون الحكم والسياسة والقضايا الدنيوية، في حين اقتصرت وظيفة المعبد على القضايا الدينية.
واختلف شكل العلاقة بين الدين والسياسة مع قدوم الديانات السماوية، لا سيّما في ظلّ اليهودية والإسلام في بدايات ظهورهما، وذلك من جهة الجمع بين وظيفتي النبوّة والحاكم. أمّا بالنسبة إلى المسيحية، فقد عرفت هذه الظاهرة لاحقاً، بعد أن تمكنّت مؤسّسة الكنيسة من امتلاك مختلف الأوراق التي منحتها القوّة، التي تؤهّلها لفرض رأيها على الحاكم، أو حتى انتزاع وظيفة الحكم وممارسته من خلال البابا، ومن يفوّضهم من رجال الدين في الكنيسة لمساعدته في القيام بمهامه. وبعد قرون من التناحر والصراعات بين الدول الأمبراطورية ذات الأيديولوجية الدينية في أوروبا خاصّة، كانت معاهدة وستفاليا عام 1648، التي أسّست لظهور دول هي أقرب من جهتها الدلالية إلى مفهوم الدولة في عصرنا الراهن، وما تميّزت به الدول المعنية هو التزامها الانتماء القومي عوضاً عن الانتماء الديني أو المذهبي. هذا مع استثناءات هنا وهناك، من ناحية التركيز في الطابع المذهبي أو حتى الديني في المقام الأوّل، خاصّة في منطقة البلقان؛ وفي أوروبا نفسها بصورة عامّة، بعد أن أرغم التحوّل نحو المذهب البروتستانتي كثيرين على الهجرة إلى أميركا، وكان ذلك تحت وطأة أمل الحصول على فرصٍ معيشية أفضل هناك. وفي هذا الأجواء تبلورت مختلف النظريات القومية التي ساعدت الحكّام في عملية التحرّر من سيطرة البابا الكاثوليكي، من خلال التوافق على ضرورة احترام مبدأ السيادة، والتوجّه نحو بناء الدول القومية، والدخول في تنافس وصراع قوميين مع القوى الأوروبية الأخرى في ميدان التسابق من أجل السيطرة على المستعمرات، حيث الأيدي العاملة الرخيصة والثروات الباطنة، والتحكّم بالممرّات المائية وطرق التجارة العالمية. وكانت حصيلة هذا التنافس والصراع حربَين كونيتَين أسفرتا أوروبياً عن تجاوز مفهوم الدولة القومية، والتوجّه نحو الدولة المدنية الحيادية، هذا رغم استمرارية وجود التوجّهات القومية والعرقية بصيغها المختلفة: من نازية وفاشية وعرقية استعلائية تجاه المهاجرين على سبيل المثال، ولكن التوجّهات والنزعات أو الأيديولوجيات المذكورة، فقدت مع الوقت شعبيتها، ولم تعد تمثّل اليوم العامل الحاسم في اللوحة السياسية الأوروبية.
أمّا في منطقتنا فقد أدخلت دولها، التي كانت موجودةً قبل الحرب العالمية الأولى، التعديلات على أنظمتها ومؤسّساتها، لتصبح أقرب إلى النموذج الأوروبي الذي اعتبرته النموذج الحداثوي المنسجم مع العصر. بينما تشكّلت الدول الأخرى وفق مقاييس الدول المنتصرة في الحرب، ويُشار هنا على وجه التخصيص إلى كلٍّ من فرنسا وبريطانيا، هذا رغم الاستثمار البريطاني في التوجّهات القومية، بينما ركّزت فرنسا في موضوع الأقلّيات الدينية، خاصّة المسيحية، وذلك وفق حسابات ومصالح كلّ طرف.
ومع حصول دول المنطقة على استقلالها، واستفحال الخلافات بين أجنحة السلطات المحلّية، التي حكمت الدول المعنية بموجب توافقات مع الدول المستعمرة ذاتها، أو تفاهمات القوَّتَين العظمين، اللتين فرضتا نفوذهما في الساحة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (ويُشار هنا إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي)، باتت الأيديولوجية القومية المطعّمة بنكهة اشتراكية أداةَ الشرعنة بالنسبة إلى الأنظمة الجمهورية العسكرية، بينما كانت الأيديولوجية الدينية الإسلامية، والدعوة إلى إحياء دولة الخلافة الإسلامية (بصورة أساسية) أيديولوجيا خاصّة بالمعارضة الإسلامية. وفي الحالتَين، كان ما يطرح من الحكومات ومعارضاتها يتجاهل الواقع الدولي الجديد، ومحدودية الإمكانات، والحاجة إلى التكيّف مع توجّهات العصر ومقتضياته، إلى جانب ضرورة التكيّف مع معطيات الوضعية الجديدة في الصعيد الداخلي.
واليوم، وبعد مرور نحو ثمانية عقود من الإخفاقات التي أعقبت الاستقلال، يُلاحظ أن غالبية دول منطقتنا ما زالت تعاني وطأة الأيديولوجيتَين المعنيتَين، رغم تعرّض الأيديولوجيا القومية لإخفاقات كبرى (هزيمة يونيو1967، والخلافات الوجودية بين نظاميّ البعث في سورية والعراق على سبيل المثال) أثّرت في شعبيتها، وأسهمت في ابتعاد النخب الفكرية عنها. هذا بينما تصدّرت الأيديولوجية الإسلامية المشهد، لا سيّما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ورفع الغطاء عن الأحزاب الشيوعية، لتعلن أن الإسلام هو الحلّ، من دون أن تراعي الحاجات الحقيقية لمجتمعاتنا، ومن دون أن تفصح عن سرّ البلسم السحري، الذي وعدت به، بناءً على توجّهات تعبوية لم تأخذ المتغيّرات المحلّية والإقليمية والدولية بعين الاعتبار.
ومن نتائج هذه التحوّلات الأيديولوجية الكبرى، التي أثّرت في واقع دول ومجتمعات منطقتنا في يومنا الراهن، لا سيّما في سورية، ظاهرة اتساع الشرخ الحاصل بين أصحاب التوجّهات المدنية العلمانية من جهة، وأنصار التوجّهات الإسلامية من جهة ثانية. فبينما يرى الفريق الأول في الثاني، لا سيّما من هم أتباع التيّارات المتشدّدة التكفيرية، خطراً يهدّد الأمن الوطني والسلم المجتمعي، يرى الفريق الثاني في الأول ملاحدةً، يمثّلون خطراً يهدّد الهُويَّة المجتمعية والقيم الإسلامية. وفي الحالتَين، يبدو أن الأحكام العامّة والصورة المسبقة المتخيّلة، فضلاً عن النزعات التنافسية، هي التي تساعد في إطلاق هذه الأحكام المتشنّجة التي يتّخذها كلّ فريق في مواجهة الآخر. ولهذا لا بدّ من تحديد مضامين المصطلحات ذات العلاقة حينما نبحث في إمكانات التعايش بين الإسلام والعلمانية. فالجماعات الإسلامية تختلف في ما بينها من جهة تعريفها لطبيعة الإسلام الذي تدعو إليه، ويشار هنا إلى إسلام الصوفية وإسلام الفقهاء، والإسلام السياسي بصيغه المختلفة. هذا إلى جانب التديّن الشعبي المعتدل غير المُسيَّس، أو إسلام السوق (إسلام البيزنس)، على حدّ تعبير الراحل صادق جلال العظم. والعلمانية هي الأخرى لها أشكال مختلفة، تراوح بين العلمانية المتوحّشة، التي سادت فرنسا والاتحاد السوفييتي؛ والعلمانية المعتدلة، التي تتمحور بصورة أساسية حول مبدأ الحيادية الإيجابية للدولة تجاه سائر مواطنيها وجماعاتها الفرعية، وهي الحيادية التي تتشخّص في عدم التدخّل بأيّ شكل من الأشكال في عقائد المكوّنات المجتمعية، بل تحترم خصوصية كلّ مكوّن، وتوفّر الظروف المناسبة ليتمكن أتباع كلّ عقيدة من أداء عباداتهم وطقوسهم، وممارسة حرّية التعبير بكلّ أريحية واحترام.
هذا النموذج هو السائد حالياً في دول أوروبا الغربية، وما زال معتمداً إلى هذه الدرجة أو تلك في كلّ من تركيا والهند وماليزيا وإندونيسيا. وحتى تتمكّن الدولة من أداء دورها الإيجابي، وواجباتها، تجاه سائر مواطنيها من دون أيّ تمييز على أساس الدين أو المذهب أو القومية أو الفكر، لا بدّ أن تُعامل (وتقدّم نفسها) على أنها مجرّد جهاز إداري على مسافة واحدة من الجميع. مهمّة هذا الجهاز تقديم الخدمات لسائر المواطنين من دون أيّ تمييز، إلى جانب احترام خصوصياتهم الدينية والمذهبية والقومية والفكرية، والإقرار بسائر الحقوق المترتبة على ذلك. أمّا الإصرار على وضع تعريف لهُويَّة الدولة، فهذا فحواه فتح الأبواب أمام جملة خلافات مجمتعية، وتكريس المشكلات المزمنة التي عانت منها مجتمعاتنا التي تتميّز بالتعدّد والتنوّع على صعيد الانتماءات والتوجّهات. فالهُويَّة تتسم بها المجتمعات، سواء على مستوى المجتمع الوطني العام أو على مستوى المجتمّعات الفرعية، التي تندرج ضمن إطار المجتمع الوطني، الذي يشمل الجميع. أمّا الوظيفة الإدارية التي تخدم وتحترم سائر الهُويَّات، الرئيسة والفرعية فهي من اختصاص التكنوقراط، الذين يعملون في مختلف مؤسّسات الدولة وأجهزتها ضمن إطار نظام سياسي عامّ، يوافق عليه الشعب بموجب دستور يشارك في صياغته ممثلو سائر المكوّنات المجتمعية، والتوجّهات السياسية، ويعتمد بصورة رسمية بعد استفتاء وطني عام عليه، ليكون ضامناً لحقوق الجميع. فالمكوّنات السورية جميعها شريكةٌ في الوطن والمصير والمستقبل، ولا يجوز في هذا المجال أيّ تفضيل أو تهميش لصالح أو ضدّ) هذا المكوّن أو ذاك من المكونات الوطنية السورية. هذا إذا كانت النيّة معقودة على بناء وطن ودولة، ومعالجة الجروح العميقة في النسيج المجتعي الوطني على أسس سليمة ترنو نحو المستقبل، بعد التحرّر من العقلية الماضوية وآثارها السلبية.
العربي الجديد
—————————
سوريا في مواجهة قاسية مع أزمة نقص المياه/ هيام علي
تعاني التغيرات المناخية والجفاف وتراجع سقوط الأمطار ومتخصصون: حصة الفرد منها انخفضت إلى 500 متر مكعب سنوياً و30 في المئة من الأراضي الزراعية خارج الخدمة
السبت 29 مارس 2025
تشير البيانات المحلية إلى أن حصة المواطن السوري من المياه دون خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب سنوياً، وتقول وزارة الموارد المائية في سوريا إن “كلفة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب فحسب تحتاج ما بين 500 و700 مليون دولار أميركي”
يحتل ملف أزمة المياه صدارة التحديات التي تواجه سوريا، فمن جهة تعاني الدولة التغيرات المناخية وانحباس الأمطار، ومن جهة أخرى تعاني محدودية الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الطلب عليها، مع إضافة إلى أزمة الفاقد الكبير في الشبكات والحاجة الملحة إلى رفع كفاءة إدارتها.
وتشير البيانات المحلية إلى أن حصة المواطن السوري من المياه دون خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب سنوياً، وتقول وزارة الموارد المائية في سوريا إن “كلفة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب فحسب تحتاج ما بين 500 و700 مليون دولار أميركي”، هذا رقم كبير جداً لبلد يعاني حرباً وخزائنه خاوية واقتصاده مدمر، لكن لا بد من التحرك فكل الملفات والاستحقاقات يمكن أن تؤجل أو تتأخر ولكن ملف أزمة نقص المياه لا يمكن التأخير فيه والتساهل معه، لأنه لا حياة ولا إعادة إعمار ولا زراعة وتطور وازدهار من دون توفر المياه؟
وتعاني سوريا عجزاً مائياً يبلغ 1.1 مليار متر مكعب والأرقام ترتفع سنوياً تجاه العجز المائي، وتنخفض كميات سقوط الأمطار في ظل تنامي ظاهرة التغير المناخي مصحوباً بالجفاف والتصحر، مما يضع البلاد أمام مواجهة عاجلة مع تحدي المياه بجميع استخداماتها، خصوصاً أن الدراسات قد حذرت من خطر الجفاف العالمي وتوقعت أن تشهد سوريا “التي تقع في المرتبة 31 عالمياً بين الدول التي ستعاني الجفاف” عجزاً مائياً مع بداية عام 2030.
وفي حديث خاص إلى “اندبندنت عربية” قال المتخصص في قطاع المياه ووزير المياه السابق المهندس نادر البني، إن “قطاع المياه هو محور أساس وهدف رئيس من أهداف التنمية المستدامة”، مضيفاً “كنا نسعى إلى تحقيق تعظيم دور المياه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رغم الصعوبات التي كانت تواجهنا وأهمها الجفاف والهدر والتلوث والفوضى في حفر الآبار العشوائي واستنزاف المياه الجوفية”. وأشار إلى أن الحرب التي حلت بالبلاد منذ عام 2011 تركت أثراً إضافياً كبيراً في قطاع المياه، إذ توقفت أعمال الاستصلاح، ودُمر جزء كبير من البنية التحتية لقطاع المياه والري، وحدث تسرب كبير في الكوادر الفنية وهجرة الفلاحين أراضيهم وخروج أكثر من 30 في المئة من الأراضي الزراعية من الخدمة، وانخفض الإنتاج الزراعي وأصبحت سوريا تستورد القمح بدلاً من إنتاجه، كل ذلك إلى جانب استنزاف المياه الجوفية خصوصاً في مدن الحسكة ودمشق وريفها.
وأوضح البني أن “متوسط حصة الفرد من المياه انخفض من 750 متراً مكعباً سنوياً إلى 500 متر مكعب سنوياً، في حين أن المعدل العالمي 1000 متر مكعب للفرد سنوياً”، وارتفعت نسبة الهدر في شبكات مياه الشرب من 40 إلى 46 في المئة ووصلت في بعض الأماكن إلى 60 في المئة، إضافة إلى تدمير بعض محطات التصفية ومحطات الضخ وشبكات الري. وتابع البني أن “أخطر ما أخشاه أن تتشظى الموارد المائية وهو ناقوس الخطر الذي يجعلنا غير قادرين على التحكم في الموارد المائية في سوريا التي تقدر بنحو 19 مليار متر مكعب سنوياً”.
4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في سوريا تعتمد على الأمطار
وفي حديثه عن أخطار الجفاف ونقص الأمطار، قال البني، “وفقاً للدراسات الدولية فإن الشرق الأوسط سيتأثر سلباً جراء تبدلات المناخ، ومن المرجح أن تصبح هطولات الأمطار غير سهلة التنبؤ من ناحية الشدة والمدة، وبالنسبة إلى سوريا فإنها تواجه فترات جفاف متكررة، لها عواقب شديدة على الموارد المائية وتحدث مرة كل 8 – 10 أعوام، لذا فإن فترات هطول المطر وتباعدها تؤدي إلى اختلال هيدرولوجي وحصول طقس جاف يؤثر في سبل العيش للسكان، ويشكل خطراً على الصحة العامة والحيوانية وخسائر بالتنوع البيولوجي ويخفض القوة الشرائية ويزيد عدد المعدمين ويؤدي إلى نزوحهم من الأرياف، إذ إن 30 في المئة من الأسر السورية مرتبطة بالزراعة، وتتدهور الأراضي وتنخفض إنتاجيتها، إذ إن أكثر من 4 ملايين هكتار (الهكتار يساوي 10000 متر مربع) من الأراضي الزراعية تعتمد على مياه الأمطار، واستنزاف المياه الجوفية، وقد تؤدي إلى توترات اجتماعية”.
وأكد البني أنه “لا بد لسوريا من أن تتجه إلى اعتماد إستراتيجية وطنية لإدارة الجفاف تتضمن تطوير قواعد البيانات المناخية والاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على سياسات وإستراتيجيات خاصة بإنشاء نظم مستدامة لتخفيف آثار الجفاف وإدارتها ووضع قائمة التدابير التي ينبغي اتخاذها، ويجب أن تشمل الرقابة ونظم الإنذار المبكر وتخطيط تدابير الطوارئ في حال الجفاف إلى جانب تدابير الإغاثة وإعادة التأهيل”.
إنتاج سوريا من مياه الشرب لا يزيد على 1.4 مليار متر مكعب سنوياً
ويقدر البني احتياج سوريا للمياه العام الحالي بنحو 1.8 مليار متر مكعب سنوياً مع بدء عودة المهجرين واللاجئين إلى سوريا، والشروع بعملية إعادة الإعمار، مع الإشارة هنا إلى أن إنتاج سوريا لا يزيد على 1.4 مليار متر مكعب سنوياً، إضافة إلى هدر الشبكات وجفاف بعض الآبار، وتلوث المياه وعدم توفر الطاقة، علماً أن عدد المستفيدين من شبكات مياه الشرب نحو 94 في المئة من عدد السكان بمعدل 98 في المئة للمناطق الحضرية و88 في المئة للريف، ويبلغ طول شبكات المياه نحو 70 ألف كيلومتر بأحجام مختلفة.
وأشار وزير المياه السابق إلى ازدياد حدة الأزمة في محافظتي حلب ودمشق بسبب الحرب وما رافقها من فترات جفاف، في حين تبدو مياه الشرب تحدياً لا يمكن تجاهله في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق.
الجفاف ونقص المياه قلصا مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى 13 في المئة
وحول القطاع الزراعي قال البني إن “سوريا دولة زراعية بامتياز، إلا أن الحرب واستنزاف المياه الجوفية والجفاف المتكرر وهجرة الفلاحين تركت أثراً في الإنتاج الزراعي، خصوصاً في محافظات الحسكة وحلب وإدلب وحماة، وانخفضت إنتاجية المحاصيل الزراعية الإستراتيجية إلى الربع مما كان عليه قبل الحرب، وزاد الطلب على استيراد القمح، وهذا يعني أن نقص المياه سيؤثر في الأمن الغذائي وستكون آثاره كبيرة اجتماعاً، لذا فلا بد من اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق الري الحديث ودعمه وتفعيل عمل جمعيات مستخدمي المياه وزيادة الإنتاجية في واحدة المساحة، وعلى وزارة الزراعة رفع الجاهزية لترشيد الفلاحين وتوعيتهم وزيادة المراكز البحثية لاختيار أصناف مقاومة للجفاف، وزيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي واستخدام مياهها في الري المقيد، إذ طرحت الحكومة السابقة 284 محطة معالجة بأحجام مختلفة، ولم تنفذها”.
ولفت إلى أن كمية مياه الصرف الصحي في سوريا يقدر بنحو 900 مليون متر مكعب سنوياً”، قائلاً “بينما المياه الصناعية تقدر بنحو 400 مليون متر مكعب سنوياً وعلينا الاعتراف بها كمصدر مائي إضافي بعد معالجتها، وينبغي وضع إستراتيجية لذلك”.
وأوضح البني أن القطاع الزراعي كان يسهم بأكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي قبل عام 2011 قبل أن ينخفض إلى 13 في المئة حالياً، وكانت المنتجات الزراعية تشكل نحو 16 في المئة من إجمال الصادرات واليوم أصبحت تُستورد، بل إن مساحة الأراضي الزراعية المستثمرة في سوريا كانت قبل 2011 نحو 5.7 مليون هكتار، وهذه مساحة في حاجة كبيرة إلى المياه، سواء كانت أمطاراً أو مياهاً جوفية وأنهاراً وبطبيعة الحال عندما يحصل الجفاف فإن التوجه يكون لاستنزاف المياه الباطنية وهو الملف الأكثر خطورة، ولا سيما في محافظات الحسكة ودمشق وريفها، لذلك لا بد من أن تشمل السياسة الخاصة بإدارة الجفاف برامج تقلل من استهلاك المياه الجوفية للري واعتماد أساليب ري حديثة تقلل من الهدر وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، لذا فالتعافي لا يمكن أن يحصل إلا إذا نفذت الحكومة سياسة رشيدة لإدارة الطلب على الموارد المائية، تضمن العودة للأرض عبر تأمين الخدمات في الريف ودعم الفلاحين، وهذا الأمر يحتاج إلى الاستقرار والتمويل.
إستراتيجية محلية لإدارة الطلب على الموارد المائية
وحول الهدر كأحد أهم المشكلات التي يعانيها قطاع المياه في سوريا، أرجع البني السبب إلى قدم شبكات المياه وسوء تنفيذها وسرقة المياه وضعف الكادر الفني ونقص التمويل، مشيراً إلى أن تسعيرة المياه لا تخفف من الهدر، وإنما ضبط الشبكة من الهدر والسرقة وتأهيل الكادر الفني والتوعية هما الأساس.
ولفت إلى أن معالجة الهدر مسألة معقدة جداً وتحتاج إلى إستراتيجية إدارة الموارد المائية واستبدال بمقولة إدارة الموارد المائية إدارة الطلب على الموارد المائية، وأكد أن سوريا وضعت إستراتيجية وبرامج تنفيذية لذلك تحتاج إلى 15 عاماً وتمويل يقدر بنحو 1180 مليار ليرة سورية، تقوم على ثلاث مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى تكون للأعمال الطارئة والتعافي المبكر للبنية التحتية، بينما المرحلة الثانية متوسطة المدى وهي أولويات الاستثمار في استصلاح الأراضي وتخفيف الهدر، وبناء محطات المعالجة وزيادة الإنتاجية، وأخيراً المرحلة الثالثة وهي إستراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية والاستفادة من كامل حصة سوريا من مياه نهري دجلة والفرات والوفر في معالجة الهدر، وكل ذلك يتطلب تمويلاً واستقراراً.
إسرائيل تحتل أراضي سورية غنية بالمياه العذبة
المتخصص في شؤون المياه، أعرب عن خشيته من التشظي، فسوريا دولة تعتمد بصورة كبيرة على مصادر المياه التي تنبع من دول الجوار “الفرات ودجلة” من تركيا، و”العاصي” من لبنان، وهناك أيضاً حوض اليرموك. ووصف البني الاتفاقات التي تحكم العلاقة مع دول الجوار بملف المياه بـ”المعقدة” التي تحتاج إلى متابعة سياسية كبيرة لحل إشكالات وخلافات عدة حول تقاسم الحصص بين الدول المتشاركة للمياه “سوريا والعراق وتركيا والأردن”، ولا سيما لجهة تحديد التدفق المائي وحصة كل دولة، والأمر ذاته بالنسبة إلى نهر العاصي الذي اتفق عليه مع الأتراك لبناء سد الصداقة، وكذلك حوض اليرموك مع الأردن والكبير الجنوبي والشمالي مع تركيا ولبنان.
أضاف أن الأنهار ليست عابرة للحدود وإنما هي أنهار دولية مشتركة، وهي من أهم المصادر للتنمية الزراعية والصناعية والاجتماعية، قائلاً “أتمنى بعد عودة العلاقات مع تركيا أن تتحسن علاقات حسن الجوار والاهتمام بملفات المياه المشتركة وتنميتها لمصلحة شعوب المنطقة، مع الإشارة هنا إلى المياه المتدفقة من نهر الفرات باتجاه سوريا هي بحدود 200 متر مكعب في الثانية، في حين يجب أن تحصل على 500 متر مكعب في الثانية بموجب الاتفاقات الموقعة مع تركيا. ولفت البني إلى أن إسرائيل تحتل أراضي سورية غنية بالمياه العذبة، خصوصاً في جبل الشيخ ويجب العمل على إعادتها، إذ يمكن الاستفادة منها في تخفيف المعاناة عن السكان في مناطق جنوب سوريا، داعياً إلى العمل على خوض جولات دبلوماسية وفنية لإعادة الأرض إلى سوريا. وحمّل المتخصص السابق لدى الـ”إسكوا” الحرب مسؤولية التقصير في إقامة مشاريع المياه في سوريا، إذ لم ينفذ أي مشروع جديد خلال الأعوام الـ10 الأخيرة.
———————————
التقارب السوري التركي ومواجهة القوى المعادية للنظام السوري/ رياض معسعس
تحديث 01 نيسان 2025
يقف النظام السوري الجديد على حبل مشدود في محاولة تثبيت أركان حكمه داخليا بتحقيق الأمن، والسلم الأهلي، والعدالة بقصاص كل من تلوثت يداه بدماء السوريين، وتفعيل عجلة الاقتصاد والسعي حثيثا برفع العقوبات التي كانت مفروضة على النظام المخلوع، وإعادة البناء لكل ما دمره النظام البائد، والاستعداد لعودة حوالي 8 ملايين لاجئ من الخارج، وأربعة ملايين نازح، ورفع مستوى معيشة المواطن، وبناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة، وعلى رأسها الجيش السوري بضم كل الضباط والعناصر المنشقة عن جيش النظام المخلوع، وصياغة دستور دائم للبلاد يأخذ بعين الاعتبار كل الخصوصيات لجميع مكونات الشعب السوري، وفتح الباب أمام تشكيل الأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان حريتها في العمل، وملفات عديدة مفتوحة تجعل أي حكومة يتم تعيينها من عتاة التكنوقراط أمام صعوبات جمة يتوجب عليها التغلب عليها. لكن الأصعب من ذلك أيضا هو تحقيق سلامة الأراضي السورية وسيادتها وحمايتها من التقسيم، ومن مخططات القوى الخارجية، وخاصة المحيطة بها أو التي كان لها نفوذا فيها سابقا والتي تتربص بها شرا، وعلى رأس القائمة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهنا تكمن عقدة النجار.
التحالف مع تركيا
لا يمكن لسوريا التغاضي عن الجار التركي فعلاقتها مع هذا الجار تعود إلى عام 1516 التي دخلها بعد انتصاره على المماليك في معركة مرج دابق بقيادة السلطان سليم الأول، (والتكية التي بناها في دمشق ماثلة إلى اليوم تؤرخ لهذا الحدث،) ومكث في سوريا لغاية سقوط السلطنة بعد الحرب العالمية الأولى، وكان يعتبرها (سوريا الكبرى) درة تاج طوب قابي. ورغم الخطأ الكبير الذي ارتكبه العرب في تحالفهم مع الدول الغربية المعادية لها والذي جر عليهم ويلات وعد بلفور، وسايكس بيكو، وقرارات سان ريمو بالانتداب، بقيت تركيا الملاذ الأخير لتشتت الأنظمة السورية المتعاقبة بين تحالفات عربية، وولاءات خارجية وضعها في خضم تقلبات عنيفة، وكان النظام البائد قد جلب العداوة مع تركيا بدعمه لحزب العمال الكردستاني قبل أن يتخلى عنه في معاهدة أضنة في العام 1994. والتخلي عن المطالبة بلواء اسكندرون الذي قدمته فرنسا لتركيا كهدية لثنيها عن الدخول في الحرب العالمية الثانية كحليف للمحور الألماني الإيطالي، كما تخلى سابقا عن الجولان في حرب النكسة. مع اندلاع الثورة السورية فتحت تركيا أبوابها أمام اللاجئين السوريين (حوالي 4 ملايين سوري)، ودخلت تركيا كطرف في المعادلة السورية مع القوى المتحالفة مع النظام المخلوع أي روسيا وإيران، لكن على عكس هاتين القوتين كانت تركيا تدعم المعارضة السورية السياسية والعسكرية، وخاضت معارك معها لتحرير أكثر من مدينة من قوات سوريا الديمقراطية «الكردية» المدعومة أمريكيا. ورغم تخلي الدول العربية (ما عدا قطر) عن الشعب السوري وثورته، والتطبيع مع النظام البائد، حافظت تركيا على موقفها من المعارضة السورية، وفاجأت العالم بدعمها لها لإسقاط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. هذا الموقف وضعها في مواجهة مباشرة مع كل من روسيا، وإيران، وخاصة دولة الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تربطها مع نظام المخلوع علاقات مصالح متبادلة منذ تخلي والد المخلوع حافظ الأسد عن الجولان السوري، ولم يرق لها سقوطه بتاتا فدأبت على تنفيذ سلسلة من الاعتداءات المتكررة والتوغل في الأراضي السورية، وتحريض المكونات الدرزية والكردية ضد الإدارة الجديدة.
المواجهة مع إسرائيل
في حمأة أحداث غزة والضربة التي تلقتها دولة الاحتلال بعملية «طوفان الأقصى» والمستمرة إلى اليوم، تلقت الضربة الثانية بسقوط النظام السوري الذي كان يؤمن وجودها في الجولان المحتل بعد اتفاق فصل القوات في العام 1974 إذ منذ ذلك التاريخ لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه الأراضي المحتلة، ولا حتى محاولة واحدة لتحرير الجولان عسكريا، أو دبلوماسيا، بل على العكس كانت إسرائيل تقصف وتنتهك الأراضي السورية باستمرار بعد اندلاع الثورة السورية لتدمير منشآت حزب الله والحرس الثوري الإيراني وفصائل أخرى جلبها بشار الأسد المخلوع لحماية نظامه من السقوط، ورغم كل الانتهاكات لم يكن رد النظام سوى كلام في كلام. واليوم بعد سقوطه تستمر دولة الاحتلال بضرب مراكز الجيش السوري أيضا دون رد من الإدارة الجديدة التي لا ترغب بفتح جبهة مع العدو تؤدي إلى فوضى كبيرة في البلاد لا يحمد عقباها، بل حتى لا تمتلك الإمكانيات العسكرية والمادية لمواجهتها، وهنا سيأتي الدور التركي في تأمين الحماية بتوقيع معاهدة مع الإدارة الجديدة. ويتم الحديث عن بناء قواعد عسكرية تضم دفاعات جوية متطورة تم بحثها في زيارة الرئيس أحمد الشرع لأنقرة، وهذا التحالف بين دمشق وأنقرة يجعل هذه الأخيرة في مواجهة مباشرة مع دولة الاحتلال التي تخشى عودة بناء الجيش السوري والمطالبة بتحرير الجولان، وقال مصدر أمني إسرائيلي إن «المواجهة بين تركيا وإسرائيل في المنطقة السورية أمر لا مفر منه نتيجة محاولة أردوغان المساس بحرية العمل الإسرائيلية، وفي منتصف يناير/كانون الثاني طالب أردوغان إسرائيل إنهاء الأعمال العدائية التي تمارسها في سوريا، وإلا فإن النتائج التي ستظهر ستضر بالجميع. وهنا تكمن عقدة النجار الثانية. فتركيا العضو الثاني في حلف شمال الأطلسي تجعل إسرائيل أن تعد للعشرة قبل التحرش بها خاصة وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى حصر المواجهة مع إيران فقط، وعدم فتح جبهات أخرى، والعمل حثيثا على تحقيق عمليات تطبيع تشمل أكثر من دولة عربية وعلى رأسها العربية السعودية، وقد صرح ترامب بأن أمر سوريا قد فوضه لتركيا، وتحدث المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قائلا بأن سوريا ولبنان باتا أقرب من أي وقت مضى للتطبيع مع إسرائيل. ويبدو أن الإدارة الأمريكية التي أرسلت قائمة بالشروط التي تطالب فيها الإدارة الجديدة في سوريا تحقيقها تريد أن تربط رفع العقوبات أيضا بمسألة التطبيع، وتقول بعض المصادر الفلسطينية بأنها أيضا طلبت من دمشق أن تمنح الجنسية السورية للاجئين الفلسطينيين (حوالي 600 ألف لاجئ فلسطيني يتمتعون بكل حقوق المواطن السوري ما عدا الجنسية لحماية حق العودة، وبعملية التجنيس ستسقط عنهم بطاقة الأنروا التي تضمن لهم هذا الحق)، وهذا يضع الإدارة الجديدة أيضا أمام عقدة نجار ثالثة يصعب حلها. وهكذا يبدو المشهد بأن الوضع في سوريا يتطلب الكثير من الإدارة الجديدة الكثير من العمل، والكثير من الحذر، وأكثر من ذلك التعامل مع القوتين العظميين اللتين تحتلان أيضا مراكز في سوريا ولا ترغبان حاليا بالتخلي عنها.
كاتب سوري
القدس العربي
—————————-
من يملك حقّ السرد؟/ سمر يزبك
01 ابريل 2025
في مواجهة علنية نادرة، وقفت الحقوقية كفاية خريم أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان، متحدّثةً بجرأة عن الانتهاكات الجنسية التي تتعرّض لها نساءٌ فلسطينياتٌ تحت الاحتلال الإسرائيلي. لم تُذكر أسماء الضحايا، لكن مجرّد طرح القضية بهذا المستوى من التحدّي يعكس تحوّلاً جوهرياً في الخطاب الحقوقي، لم يعد التوثيق مجرّد تسجيل للجرائم، بل أصبح تحدّياً مزدوجاً: مواجهة المعتدي المحتلّ، والتصدّي لمنظومة اجتماعية تُلزِم الضحايا الصمت حفاظاً على “الشرف”.
لطالما استُخدم العنف الجنسي أداةَ إخضاع في سياقات الاحتلال والاستبداد، ليس لإيذاء النساء فقط، بل لإذلال الجماعة بأسرها، ما عزّز ثقافة الصمت والخوف. في الحالة الفلسطينية، يتجاوز القمع ممارسات الاحتلال ليشمل مجتمعاً يُحمِّل الضحيةَ مسؤوليةَ انتهاك جسدها، ويطالبها بالكتمان درءاً للعار. ليست هذه الديناميكية فريدةً، بل تكرّرت في البوسنة وسورية، حيث استُخدم الاغتصاب عقاباً سياسياً، فيما فُرض على الضحايا الصمت لحماية صورة المجتمع.
عندما أنجزنا مع المخرجة الفرنسية مانو لوازو فيلم “الصرخة المخنوقة”، وثّقتْ المخرجةُ شهادات سوريات تعرّضن للعنف الجنسي، فوجدن أنفسهن مهدّدات ليس من الجناة فقط، بل أيضاً من عائلاتهن التي رأت في حديثهن خيانة. هذا الواقع يكشف منظومةَ قهر مزدوجة، إذ تواجه النساء الاعتداء، ثمّ النبذ والانتقام. وسط هذه التناقضات، تظهر ازدواجيةٌ صارخةٌ في التعامل مع قضايا الاغتصاب. فعلى الرغم من تفنيد تقارير عديدة مزاعم تعرّض إسرائيليات للعنف خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (2023)، استُخدمت تلك الادعاءات لحشد الرأي العام الغربي. في المقابل، تُحاصر الفلسطينيات اللاتي يعانين من انتهاكات ممنهجة بالصمت، ليس بسبب الاحتلال فقط، بل بسبب مجتمع يخشى كشف الحقيقة. تطرح هذه الازدواجية أسئلةً جوهريةً: من يُسمح له بالكلام؟ ومن يُفرض عليه الصمت؟ وكيف تتحوّل أجساد النساء ساحاتِ معركةٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ؟… يُفهَم العنف الجنسي نتاجاً لمنظومةٍ قمعيةٍ تُخضِع النساء. ليس الصمت هنا خياراً، بل قانوناً اجتماعياً غير مكتوب يعاقب من يجرؤ على كسره. وعندما كسرت كفاية خريم هذا الصمت لم تكتفِ بكشف انتهاكات الاحتلال، بل تحدّت أيضاً السلطة الأبوية التي تجعل من الضحايا مذنبات.
لكن كيف تتحوّل هذه الشجاعة الفردية قوّةَ تغيير جماعية؟… لا يتحقّق ذلك من دون إعادة بناء الخطاب الحقوقي ليطرح قضية العنف الجنسي خارج قيد العار الاجتماعي، باعتباره جريمةً تستدعي المواجهة لا الإنكار. في مجتمعات تُكرِّس سلطة الرجل على جسد المرأة، يصبح هذا التحوّل ضرورةً رغم العقبات. شهادة كفاية ليست مجرّد إفصاح عن مأساة، بل خطوة نحو تفكيك نظام يُخضِع النساء للصمت وفتح باب لأسئلة أكثر تعقيداً حول العلاقة بين الاحتلال والجنس، والعنف السياسي والاجتماعي، والشجاعة الفردية والتغيير الجماعي.
عندما تقف امرأةٌ لتواجه بصوت ثابت منظومةً قمعيةً جعلت من اغتصابها أداةً ممنهجةً للإذلال، لا تواجه مغتصبها فقط، بل تتحدّى تاريخاً طويلاً من القهر والصمت المفروض عليها. هذه المواجهة ليست مجرّد فعل شخصي، بل تقلب معادلة القوّة أيضاً، إذ تنتزع الضحيةُ صوتها من فكّ الهيمنة، وتجبر المجتمع على الاعتراف بجريمتها لا بجُرمها. لطالما صُوِّرت المرأة الضحية كائناً منكسراً، رازحاً تحت وطأة العار، لكنها عندما تصعد إلى المنصّة، أو تروي قصّتها أمام العالم، تخلق صورةً جديدةً: امرأة تتحدّى، لا تستجدي؛ تصوغ خطابها الخاص بدل أن تكون مادّةً في خطاب الآخرين. يصطدم هذا الحضور العلني بموروث ثقافي يرى في الاعتداء الجنسي وصمةً اجتماعيةً أكثر منه جريمة، ما يجعل المواجهة أكثر خطورةً، إذ تتحوّل الضحيةُ متّهمة.
لكن ماذا يحدث عندما لا تكتفي المرأة بالسرد، بل تُحاكِم مغتصبها اجتماعياً وسياسياً؟… حينها يتحوّل جسدها، الذي أريد له أن يكون أداةَ إذلال، ساحةَ مقاومة. رأينا هذه المواجهة في شهادات الأيزيديات أمام المحاكم، وفي نساء البوسنة اللاتي أدلين بشهاداتهن ضدّ مرتكبي جرائم الحرب، وفي الفلسطينيات اللاتي يبدأن اليوم في استعادة أصواتهن رغم القيد المركّب من الاحتلال والمجتمع. هذه المواجهة تتجاوز الفردية، فهي لا تطالب بحقوق شخصية فقط، بل تُسائِل بنية المجتمع بأكملها: من يملك حقّ السرد؟ من يُسمح له بأن يكون ناجياً بدل أن يبقى منكوباً؟… هنا، لا تكون المرأة مجرّد شاهدة على معاناة، بل فاعلة في صياغة تاريخ جديد، فتصبح المواجهة في حدّ ذاتها فعلَ مقاومةٍ سياسياً وثقافياً يهدّد أسس الأنظمة التي قامت على تكميم أفواه النساء.
العربي الجديد
———————————-
الكرملين متمسك بالأسد… وبوتين “لا يسلم رفاق السلاح”/ رامي القليوبي
01 ابريل 2025
منذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره برفقة عائلته إلى روسيا، لم يتوقف سيل التكهنات حول مستقبل العلاقات بين موسكو والسلطات السورية الجديدة بقيادة رئيسها أحمد الشرع، ومصير قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية في الساحل السوري، والثمن الذي قد يدفعه الكرملين مقابل الإبقاء عليهما، وما إذا كان سيصل الأمر إلى تسليم بشار الأسد إلى سورية. وشهدت الأيام القليلة الماضية تجدداً للجدل حول هذه المسألة، بعد انتشار أنباء حول تقديم الشرع طلباً رسمياً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليم بشار الأسد بهدف محاكمته على الأراضي السورية، واسترداد الأموال السورية المودَعة في روسيا، وسط تشكيك في واقعية تجاوب بوتين مع مثل هذا الطلب. ثمة إجماع بين محللين سياسيين على ثبات موقف بوتين في مسألة تقديم نفسه على أنه “رجل لا يسلم رفاق السلاح” ممن خدموا مصالح بلاده ذات يوم، وتسويق روسيا نفسها أمام شركائها، من خارج الكتلة الغربية، على أنها دولة ذات ثوابت راسخة لسياساتها ولا تتخلى عن حلفائها، على عكس الولايات المتحدة.
استبعاد تسليم بشار الأسد
ويستبعد المترجم العسكري الروسي السابق، أندريه مورتازين، احتمال موافقة بوتين على طلب تسليم بشار الأسد نظراً لتعارضه مع ثوابت السياسة الخارجية الروسية في القرن الـ21، والتي تقتضي ضمان سلامة الحلفاء. متوقعاً، في الوقت نفسه، أن يؤثر هذا الموقف سلباً على المصالح الروسية في سورية، بما فيها آفاق وجود قاعدتي حميميم وطرطوس في الساحل. ويقول مورتازين، الذي خدم في سورية في ثمانينيات القرن الماضي وزارها بضع مرات بعد اندلاع الأزمة بصفته مراسلاً حربياً، في حديث لـ”العربي الجديد”: “على عكس عهد آخر زعماء الاتحاد السوفييتي، ميخائيل غورباتشيف، وأول رئيس روسي ما بعد السوفييتية، بوريس يلتسين، يخلو تاريخ روسيا المعاصر، منذ صعود بوتين إلى السلطة، من سوابق تسليم من مُنحوا حق اللجوء، ولذلك لا أتوقع أن يتم تسليم بشار الأسد، لأن ذلك سيشكل ضربة كبيرة لهيبة روسيا وبوتين شخصياً، وسيفقده دعم قادة دول الجنوب العالمي. كما يدرك بوتين جيداً أن بشار الأسد سيواجه في سورية الإعدام أو السجن المؤبد في أحسن الأحوال”.
وحول رؤيته لتأثير عزوف موسكو عن تسليم الأسد على العلاقات الروسية السورية، يوضح مورتازين: “أتوقع أن يؤثر الرفض الروسي تسليم بشار الأسد سلباً على العلاقات الروسية السورية، وقد يصل الأمر إلى المطالبة بإنهاء وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في الساحل السوري، أو المطالبة بتعويضات، أو ثمن باهظ مقابل الإبقاء عليهما. والخيار الثاني قد تقبل به موسكو بصورة غير معلنة، مع تقديم الأمر على أنه تقديم دعم لسورية في مرحلة حرجة، ولكن حتى في هذه الحالة لن يكون الوجود الروسي في سورية مستقراً، نظراً لمخاطر اندلاع موجة جديدة من الاقتتال الداخلي”.
تدني مستوى العلاقات
من جهته، يجزم الأكاديمي السوري المقيم في موسكو، محمود الحمزة، بأن روسيا لن تسلم بشار الأسد لدوافع قد تكون شخصية أكثر منها سياسية، معتبراً، في الوقت نفسه، أن ذلك يؤثر سلباً على العلاقات بين موسكو ودمشق والتي تبقى عند مستوى متدنٍ. ويقول الحمزة، الذي عارض النظام السوري من الداخل الروسي منذ عام 2011، في حديث لـ”العربي الجديد”: “في تقديري الشخصي، طرحت مسألة تسليم بشار الأسد وضباطه والأموال المنهوبة منذ بدء الاتصالات الروسية السورية، بما في ذلك أثناء زيارة الوفد الروسي إلى دمشق في فبراير/شباط الماضي، ولكنني أستبعد احتمال قبول القيادة الروسية بذلك لأبعاد شخصية أكثر منها سياسية، رغم تخليها فعلياً عن الأسد منذ دخول الفصائل المسلحة إلى حلب العام الماضي”.
ويعتبر أن الغموض لا يزال سيد الموقف في مسألة مستقبل العلاقات الروسية السورية، مضيفاً: “على مدى 14 عاماً، دعمت روسيا نظام الأسد بشكل شامل، عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً، ما يضع على عاتقها دَيناً يجب أن تعوضه للسوريين. تفكر موسكو في تطبيع العلاقات مع السلطات السورية الجديدة، وتطوير التعاون مع دمشق، ولكن السلطة السورية تبدي تحفظاً حيال عدم تجاوب روسيا في تحقيق المطالب مثل تسليم بشار الأسد، وتقديم مساعدات، وإبداء بوادر حسن نية، وإثبات الدعم الروسي للشعب السوري لا النظام السابق. ولكن المساعدات الروسية لا تزال رمزية حتى اليوم رغم قدرتها على تقديم العون في شكل إمدادات القمح وغيره من السلع الأساسية”.
بدوره، يستبعد المحلل السياسي المقرب من دوائر صنع القرار الروسية، رامي الشاعر، احتمال قبول روسيا بتسليم بشار الأسد في المرحلة الراهنة على الأقل. معتبراً، في مقال له بموقع قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية في 23 مارس/آذار الماضي، أن “مصير الأسد قضية محسومة وليست قابلة للنقاش”، معرباً عن قناعته بأن “القيادة السورية الحالية تعي ذلك تماماً”، ومذكراً بإعلان الكرملين بعد سقوط النظام السوري أنه استقبل بشار الأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية لا سياسية.
وكان الأسد وصل إلى موسكو مساء يوم سقوط نظامه، حيث حصل على حق اللجوء له ولأفراد عائلته لما تقول موسكو إنه “دواع إنسانية”، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حينها، أن بوتين بشخصه اتخذ قرار منح اللجوء للأسد وأفراد عائلته، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على دمشق. وفي وقت لا يزال فيه موقع وجود بشار الأسد مجهولاً، تشير تقارير إعلامية غربية إلى أن أفراد عائلته وأقاربهم اقتنوا بين عامي 2013 و2019 نحو 20 شقة فاخرة بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار في حي “موسكو سيتي” الذي يحتضن مقار كبريات الشركات والمصارف وبعض المؤسسات الحكومية الروسية ويعد واجهة لروسيا الرأسمالية ما بعد السوفييتية. والأسد ليس أول رئيس يلجأ إلى روسيا خلال عقد مضى، إذ استقبلت موسكو في 2014 الرئيس الأوكراني الهارب والموالي لها، فيكتور يانوكوفيتش، والذي يشاع أنه مقيم في مدينة روستوف جنوبي روسيا.
العربي الجديد
——————————————-
شاعر القبيلة وزيراً للثقافة السورية/ راشد عيسى
تحديث 01 نيسان 2025
ظلّت ابتسامة المرء ملء وجهه، مع شعور عارم بالفخر، أثناء الاستماع لكلمات الوزراء السوريين عند إعلان أول حكومة سورية بعد سقوط المخلوع الأسد.
بدا واضحاً أنه قد طُلب منهم، إلى جانب سِير ذاتية مختصرة، تضمين كلماتهم خطة عمل.
هكذا تتالت الكلمات، من بينها كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي. تحدث الوزير عن قاعدة بيانات، ومصفوفة تحديات، وتحليل أسباب، وتطوير مناهج، وخارطة للتعليم العالي، وصولاً إلى كلمته الذهب: “تعزيز الاستقلالية والحرية الأكاديمية”، و”ما أفسد جزءاً كبيراً من التعليم تَدخُّل السياسة والحزب والأمن”.
ثم وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، وبطولته مع فريقه، على مدى 13 عاماً، لا تخفى. إلى وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، الذي حتى في دعابته عن “تشات ج بي تي” بدا عارفاً تماماً لطريقه، إلى وزراء آخرين. حتى السيدة الوحيدة، الوزيرة هند قبوات، قد نجد في الركاكة اللغوية لكلمتها إضفاء لتنوّعٍ مقبول. طبعاً، فليست الحكاية سوق عكاظ، وإلا كان يجب التوقّف أولاً عند خطأ الرئيس السوري أحمد الشرع نفسه في خطاب القمة عندما رفع المضاف إليه في “وصمة عار”.
ظلّ إذاً مزاجُ السعادة طاغياً، إلى أن جاء وزيرٌ قدّمَ كلامه ارتجالاً، وأعوذ بالله من الارتجال في عالم الخطط والموازنات، ولا شك أنكم تعرفون ذلك النموذج من الحكّائين الذين يعتبرون البراعة والفصاحة في التكلّم من دون ورقة، ومن دون توقّف قدر الإمكان، بغض النظر عن الفحوى.
وما هي إلا لحظات حتى بدا الارتجال نفسه “خطة عمل”، فوزير الثقافة، محمد الصالح، شاعر، يقيم، من حيث الشكل الشعري في عصر انحطاط الشعر (لن ننسبه بالطبع إلى العصر الجاهلي حيث زمن فطاحل الشعر العربي)، بعد آية قرآنية، راح ينشد:
“لقد صُمنا عن الأفراح دهراً
وأفطرنا على طبق الكرامة
فسجِّل يا زمان النصر، سجِّل:
دمشقُ لنا إلى يوم القيامة”
“صمنا”، و”أفطرنا” و”أطباق” كلمات للمطبخ، لا للكرامة، كأن تقول مثلاً “منسف أحلام”، هل تجد في كلمة “منسف” مفردة شعرية تتواءم والأحلام؟ كذلك حين تقترن الكرامة بالأطباق. هذا عدا عن أن العبارة “صمنا وأفطرنا” تحيل فوراً إلى مثل شعبي يفسد الكلام الرفيع “صام وأفطر على بصلة”.
وعدا عن أن البيتين يخلوان كلياً من الشعر، فهما ليسا سوى ضجّةِ شِعر، فعندما تقول: “سَجّل يا زمان النصر”، علينا أن نتوقع أن العبارة التالية مرصودة لنفخ “أنا” الجمهور، والذي سيبادر إلى التصفيق، شيء يشبه أنواعاً من الموسيقى ما إن تحضر حتى تحل الدبكة معها.
بات هذا فارقاً واضحاً بين شعر مِنبريّ وآخر للقراءة. ثق أن بعض الشعر، بفضل إيقاعاته، لا يجري التمعن بمعانيه أصلاً، هو مخلوق ليلعب دور ضربة الطبل، تماماً كما مع طبول الحرب، أو طبول دبكة العرس.
أما عبارة “دمشق لنا إلى يوم القيامة”، وهي فحوى كل كلام الشاعر الوزير، التي راح أناس كثر يتناقلونها على السوشال ميديا، من فم الوزير، أو حتى بألسنتهم، فتُشعرنا بأننا إزاء نزاع حدود، تضعك أمام معادلة واهمة لـ “نحن وهم”، كأننا في خضم حرب بين قومين، قبيلتين، وعلى ما يبدو فإن الوزير يجد نفسه هنا أقرب إلى شاعر قبيلة. ولا نحسب أن الدولة الحديثة التي يحلم بها السوريون سيكون شاغلها “نحن وهم”.
عندما نصل إلى خطة الوزير في وزارة الثقافة سيكتفي بتلخيصها، ارتجالاً أيضاً، على أنها أمران: “أنْ نُفتّت ونبتعد عن كل المنظومة الثقافية التي كان يتبناها الوضيع، البائد، محتل هذا القصر”، والركون إلى “ثقافة عمل الخير، الإحسان، ثقافة التآخي،.. “، ويزيد شرحاً: “لا يمكن أن نذهب إلى ترف المعرفة في وقت تسود فيها الحاجة، ويسود فيه البؤس”! لماذا أنت هنا إذاً معالي الوزير؟! فما دامت المعرفة، والثقافة، ترفاً فلنوزّع هذه الحقيبة على “الشؤون الاجتماعية والعمل”، ووزارة الطوارئ، أو الأوقاف، فهذه أقدر على افتتاح تكايا وموائد قد ينتفع الناس بها أكثر من ترف المعرفة.
علينا أن نتوقع إذاً أن حاجات الناس ستكون دائماً في الميزان، وسيقال إن الخبز أهم من الأوبرا، وحطب المدافئ أجدى من رسم المناظر الطبيعية، وإصلاح شبكة الكهرباء أبدى من أفلام السينما،… لكن لا شيء أولى، غالباً، من شعر الوزير.
وفي الواقع، فإن شعر الوزير ضعيف للغاية (حبذا لو تعود إلى نزار قباني ومحمود درويش إن أردت أجمل الأوصاف لدمشق)، وقد انتشر فيديو له، يبدو أنه أعد تحت إشرافه، وواضح فيه الرغبة الهائلة بسقاية “الأنا” بتسليط ضوء استثنائي، وكان يكفيك لو أردت أن تنصرف إلى كتابة شعر أرفع قليلاً من القافية المبتذلة التي تنتهي بـ “ات”، مثل ابتسامات، وذاتي، ياسمينات، ملذات، سماوات، مولاتي، بريئات، ضحكاتي،.. قوافٍ تخجل القلب حقاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوزير.
ولكن ما هي مؤهلات هذا الشاب، حتى يشغل مكانة وزير ثقافة لبلد ناسُه “في جيناتهم حضارة ثقيلة جداً”، على ما يقول هو نفسه في فيديو لاحق من مسجد في ضاحية قدسيا؟
في السيرة الذاتية، كما قدّمها، وبحسب البحث على الشبكة، لا كتب، ولا مؤلفات، ولا مشاريع، سوى عمله في قناة “الجزيرة”. مذيع ببضعة برامج وحسب. وهذا حقاً باب يجب أن يفتح للنقاش وإعادة النظر، فهناك سوء فهم كبير، حيث من البديهي أن يكون المذيع في الضوء، هو الموجود على الشاشة أمام الملايين، ولكن هل مجرد الظهور هذا يؤهله ليصبح من قادة الرأي؟ يتكاثر هؤلاء بشكل لا يردّ، تتكاثر الفضائيات والقنوات التي يطل عبرها مذيعون، فيفتتح الأخيرون دكاناً على تيك توك، أو أيّ من منصات التواصل ليخبرونا بآرائهم وتحليلاتهم، حتى تسللوا بفضل سطوتهم التلفزيونية إلى زوايا الصحف، محتلين أعمدة كبار الكتّاب، وبحكم شهرتهم التلفزيونية باتوا هم الأكثر قراءة.
لا ندري إن كان محمد صالح، مذيع “الجزيرة” الذي احتل موقع وزير الثقافة، يعرف شيئاً عن حال الثقافة في بلده، هل لديه فكرة عن حال مؤسسة السينما؟ ما أُنتج من وثائقيات خلال الثورة أو قبلها؟ هل يعرف شيئاً عن وزارة الثقافة التي هو قادم إليها؟ ما أنتجته وما مرّ عليها من أسماء مثقفين؟
نأمل أن يدعى الوزير غداً إلى نقاش مفتوح مع المثقفين والمشتغلين في مجال الثقافة، عسى يعدّل في خطّته المرتجلة، وقد يلاحظ صعوبة أن يكون المرء مهندساً للثقافة في بلدِ “الحضارات الثقيلة”، وأن عدة الشغل التلفزيوني وبرامج “الفصاحة” ليس لها مكان هنا.
* كاتب من أسرة “القدس العربي”
القدس العربي
——————————–
دراما سورية 2025: أما زال التلفزيون عاجزًا عن الواقع؟/ لاء الدين العالم
1 أبريل 2025
“ربما سيكون الموسم التلفزيوني السوري في رمضان المقبل هو الأكثر حماسة وتسلية، لا لكونه الموسم الرمضاني الأول بعد سقوط النظام، بل لأن كل الأعمال التي صورت أو لا تزال تصوّر في سورية هي أعمال كُتبت وأخرجت وأنتجت في أيام نظام الأسد الأخيرة”- بهذه العبارات أنهيت مقالتي عن الدراما التلفزيونية السورية إبان سقوط نظام الأسد في نهاية العام الماضي (2024). إلا أن موسم الدراما التلفزيوني السوري في شهر رمضان لم يكن كذلك، بل اقتصر الإنتاج على أعمال لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.
اللجنة الوطنية للدراما: التلفزيون السوري بعد السقوط
شكّل سقوط النظام وهروب رأسه زلزالًا في المجتمع السوري، وهو زلزال طاول كل طبقات المجتمع وحقوله. وكونه كان حقلًا بارزًا في المجتمع السوري، تزلزل الحقل التلفزيوني أيضًا. وتعرّض مجال إنتاج الدراما التلفزيونية السورية إلى صدمة أثّرت على سير الأعمال وعلى تلقيها لاحقا. توقفت بعض الأعمال قبل أن تبدأ (مثل مسلسل “مطبخ المدينة”، إخراج رشا شربتجي، وتأليف علي وجيه) بينما تمكنت أعمال أخرى من الاستمرار في التصوير رغم تغيير الظروف الأمنية، وعلى رأسها مسلسل “تحت سابع أرض” إخراج سامر برقاوي، ومسلسل “البطل” إخراج الليث حجو الذي استمر بالتصوير بعد حصوله على الأذون الرقابية والتسهيلات اللوجستية مما سُمّي بـ “اللجنة الوطنية للدراما”.
واللجنة الوطنية للدراما هي لجنة إدارية شكلتها الحكومة المؤقتة في دمشق إبان السقوط، لإدارة ومتابعة المشاريع الدرامية التلفزيونية السورية. عملت اللجنة منذ بداية تشكلها على التواصل مع الفنانين والعاملين في الدراما التلفزيونية، سواء عبر لقاءات فردية أو جماعية بعيد السقوط. لاحقا، وفي أيام الحوار الوطني، أقدمت اللجنة على إقامة جلسة حوارية للفنانين والممثلين والعاملين في حقل الدراما التلفزيونية. لم تخرج عن اللقاء أي توصيات أو ورقة عمل، بل اقتصر الأمر على خطابات قصيرة قالها بعض المشاركين تدعم الفن السوري ودوره في إرساء السلم الأهلي. من جهة أخرى لم يكن اللقاء خاصًا بالدراما التلفزيونية السورية والعاملين فيها وحسب، بل دُعي أيضًا كتاب ومسرحيون وسينمائيون سوريون، بحيث كان اللقاء أقرب إلى لقاء تعارف بين فناني سورية بعد السقوط، ومحاولة لجمع فناني الداخل والخارج في لقاء مفتوح.
إن التحدي الأكبر أمام اللجنة الوطنية للدراما، أو أي لجنة قادمة خاصة بحقل الدراما التلفزيونية، هو إعادة هذه الأعمال إلى حقل الصناعة، بمعنى العمل على تفعيل أعمال الدراما التلفزيونية بما هي صناعة ومجال عمل واسع، يجمع بين محترفين وحرفيين وفنيين، ويشكل بيئة عمل وإنتاج وتشغيل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحالة (الدراما كصناعة) لم تتشكل يوما في سورية على المستوى الإداري. حتى في ذروة الإنتاج التلفزيوني السوري بين 2006 و2010، لم يُنظَّم العمل التلفزيوني السوري كصناعة عبر نقابات ومؤسسات، وبقي عمل اللجان التنظيمية الخاصة بالدراما حبيس الكلمات في زمن النظام البائد. من هنا، فإن التحدي الأكبر أمام أي هيئة أو لجنة حكومية خاصة بالدراما هو العمل على مأسسة وتنظيم العمل التلفزيوني السوري، وتعزيز الإنتاج الدرامي التلفزيوني بدلًا من أن يقتصر الإنتاج التلفزيوني على مسلسلين أو ثلاثة، كما هي حال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، حيث اقتصرت الدراما التلفزيونية السورية على مسلسلين اثنين رئيسيين.
“تحت سابع أرض”: الانفصام عن الواقع
عندما تشاركَ الممثل تيم حسن مع الكاتب والمخرج المسرحي عمر أبو سعدة قبل ثلاثة أعوام، تبين أن الممثل قرر تغيير مسار مسلسل “الهيبة” الذي ابتدعه، حيث العمل التجاري، والانتقال إلى أعمال جدية بتأليف كاتب مسرحي وأكاديمي. بيد أن ما حصل لاحقًا كان العكس، فأبو سعدة، هو من انزلق إلى مستوى “الهيبة”. وبالرغم من أن بداية الشراكة كانت مثمرة مع مسلسل “الزند”، ولاحقًا مسلسل “تاج”، إلا أنه سرعان ما انخفضت سوية الأعمال التي أنتجها الثنائي والتي كانت دائمًا من إخراج سامر برقاوي.
آخر أعمال المجموعة (حسن وأبو سعدة والبرقاوي) كان مسلسل “تحت سابع أرض” الذي عرض في الموسم الرمضاني الحالي. يحكي المسلسل قصة المُقدَّم موسى (تيم حسن) وعائلته، وكيف تتحول حياة الضابط الملتزم حينما يدرك أن أخيه زين (أنس طيارة) وأخته رنا (رهام قصار) يعملان في تزوير العملة النقدية. ليست حياة الضابط وحدها من تتغير، بل شخصيته أيضا، إذ يجد نفسه رويدًا رويدًا في قلب عصابة التزوير لا بل قائد عصابة خاصة لاحقًا. لا جديد في الشخصية بالنسبة لحسن، هي ذات الشخصية الذكورية البطل المقدامة، ولا جديد على صعيد الأكشن والقتال وما إلى ذلك. الجديد الوحيد ربما في “تحت سابع أرض” هو انعدام منطق الحكاية والمبالغة في الأداء.
انعدام المنطق في الحكاية ليس حكرًا على تحولات شخصية موسى، فأي شخصية درامية قابلة للتحول، لكن المنطق يغيب عن الحكاية ككل. العلاقات العسكرية داخل قسم الأمن الجنائي غير منطقية، إذ لا نجد أي دلالة على التراتبية العسكرية، والعلاقة بين موسى والمقدم فجر (جوان خضر) الذي يلاحقه غير منطقية، تتالي الأحداث على مستوى الكتابة غير منطقي، العلاقات الغرامية للضابط موسى غير منطقية هي الأخرى، ولا تخضع لأي تصاعد، بل هي تكاد تحصل من العدم وبدون مبررات درامية فعلية. تحديدًا قصة علاقته مع بلقيس (كاريس بشار) التي تتحول من الحب المفرط إلى الخيانة والبغض دون سبب. هذه اللامنطقية تندرج على واقع العمل ككل. أين تجري هذه الأحداث؟ ومتى؟ هل هي في سورية؟ في دمشق؟ قبل سقوط النظام؟ بعده؟ لا وجود لأي معلومة تحدد زمن العمل، وتبقى صور شوارع دمشق هي الوحيدة الدالة على المكان، ويبقى المتلقي أمام سؤال: هل هذه دراما واقعية سورية؟!
“البطل”: الإخراج أنقذ النص
على عكس “تحت سابع أرض” قرر المسلسل السوري “البطل”، تأليف رامي كوسا وإخراج الليث حجو، أن يخوض في الواقع السوري ويشاكله، عبر سرد حكاية قرية سورية نائية في خضم الحرب والنار. طارحا مفهوم البطل ومناقشته من خلال حكاية درامية واضحة وواقعية. الشخصيات في المسلسل منطقية ومتسقة مع جبلتها الدرامية. انطلاقًا من الشخصية الرئيسية الأستاذ يوسف (بسام كوسا) الملتزم بمبادئه وإرثه القيمي، والمتمسك بالبقاء في أرضه رغم الحرب الضروس، وبانيًا لصورة البطل الإيجابي القائمة على التضحية، ومرورًا بالبطل الرديف وهو فرج (محمود نصر) ابن الحانوتية الذي قرر الثورة على النظرة الفوقية التي يعامله بها أهل القرية عبر العمل في التهريب والتعفيش، وصولًا إلى الشخصيات الثانوية كابني الأستاذ (مريم ومجد) وحبيبيهما (مروان وسلافة).
إلا أن وضوح خطوط الشخصيات واتساقها لم ينقذ النص من الوقوع في فخ الإيقاع الرتيب، وبطء تسلسل الأحداث، ورتابة البناء الدرامي. زد على ذلك مزاج الكدَر والحزن الذي يسيطر على أحداث العمل وحكايته. إذ تكاد لا تخلو حلقة من حدث درامي قاسٍ ومؤلم. ويبدو أن مقاربة الواقع السوري التي أرادها المسلسل هي ما نحت بأحداثه تجاه جرعة زائدة من المقت والقهر. لكن حتى في الواقع السوري القاسي هناك لحظات فرح وأمل وسعادة، وهو ما افتقده المسلسل، التنوع في المزاج كما هو تنوع الحياة والواقع. وكما هو المسرح، المكان الذي اقتبس منه نص المسلسل (اقتباس عن مسرحية “زيارة الملكة” لممدوح عدوان).
الأداء والصورة هما نقاط قوة مسلسل البطل، وهما ما حمى النص غير المكتمل من الانهيار. على مستوى الأداء يقدم بسام كوسا أداء متماسكًا ومحترفًا، ويظهر فيه ملكاته كممثل مخضرم قادر على الإمساك واللعب بين خطوط البطل وقصته بين الفداء والعجز. هيما اسماعيل ومحمود نصر هما الآخران لعبا شخصيتيهما بحرفية، لكن العلامة الفارقة كانت من نصيب الممثلين الشباب سواء ثنائية مريم ومروان (نور علي وخالد شباط) أو ثنائية مجد وسلافة (وسام رضا ونانسي خوري)، إذ قدّم الممثلون الشباب مشاهد بحساسية عالية، وحوارات حيوية ورشيقة يشعر فيها المتلقي أن المكتوب هو من ارتجال الممثلين لا من جنس النص. وبالطبع هذه العملية الارتجالية أدارها المخرج الليث حجو الذي قدّم صورة غنية ومعبرة عن رحلة البطل بوجهيها. وربما أهم ما في “البطل” أنه أعاد تقديم الليث حجو كمخرج ما زال في جعبته الكثير ليقدّمه للدراما التلفزيونية السورية بعد السقوط في حال توفر النص المتين.
في عام 2006، أنتجت الدراما التلفزيونية السورية ما يقارب ستين عملًا دراميًا، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الإنتاج التلفزيوني السوري اليوم، وبعد قرابة نحو عشرين عامًا يقتصر الإنتاج التلفزيوني السوري على عملين أساسيين فقط، في الوقت الذي أنتجت فيه الدراما المصرية مثلًا 45 عملًا تلفزيونيًا. من هنا، لا يمكن القول عن موسم درامي رمضاني سوري، ولا يمكن اليوم الحديث عن دراما سورية، أو صناعة درامية سورية، بل ربما الحديث الأجدى في هذا السياق هو التأسيس لإعادة إعمار الدراما التلفزيونية السورية، إعادة إعمار على كل المستويات، بدءا بالكتابة وانتهاء بالصناعة والفرجة، فالدراما التلفزيونية كما سورية أنهكتها الحرب والشتات، ويبدو أنها بحاجة إلى إعادة بناء.
ضفة ثالثة
——————————
في مخاض الدستور السوري خلال مئة عام/ نبيل سليمان
31 مارس 2025
على إيقاع ما زلزل سورية في السادس من شهر مارس/ آذار 2025 في الساحل السوري، وقّع رئيس الجمهورية أحمد الشرع الإعلان الدستوري في 13/ 3/ 2025. وكانت لجنة صياغة الإعلان قد أنجزت أعمالها في عشرة أيام. وجاء في مقدمته أنه استُلهم من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في 25/ 2/ 2025، ومن إعلان انتصار الثورة في 29/ 12/ 2024. وفي المقدمة أيضًا أن الإعلان يأتي “حرصًا على إرساء قواعد الحكم الدستوري السليم المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة، ولا سيما دستور عام 1950 ــ دستور الاستقلال”.
في الدساتير العربية المؤقتة
في انتظار انتهاء المرحلة الانتقالية في سورية بعد خمس سنوات، بإقرار دستور دائم، يكون الإعلان الدستوري هو الدستور المؤقت. وهذا أمر تكرر بعد (الربيع العربي)، ابتداءً بتونس، حيث أصدر (رئيس الجمهورية المؤقت) مرسومًا في 13/ 3/ 2011 بمثابة إعلان دستوري، أو دستور مؤقت.
وفي ليبيا، صدر (الإعلان الدستوري المؤقت) في 3/ 8/ 2011. ومما جاء فيه أن ليبيا (دولة ديمقراطية)، وأن الشعب مصدر السلطات، وأن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتحدد القول بأن هذا الإعلان هو (دستور مصغر للمرحلة الانتقالية، وهو مؤقت).
وكانت ليبيا قد عرفت الإعلان الدستوري الأول في 11/ 9/ 1969، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي جاء بمعمر القذافي، فحكم البلاد اثنتين وأربعين سنة حتى قامت ثورة 17 فبراير/ شباط 2011. أما الإعلان الدستوري الليبي فقد استمر العمل به حتى 2/ 3/ 1977، وفيه النص على أن دين الدولة الإسلام.
في مصر، عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 صدر الإعلان الدستوري في 13/ 2/ 2011، ثم صدر الإعلان الدستوري في 30/ 3/ 2011، فالإعلان الدستوري في 11/ 8/ 2023. وإثر فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية أصدر في 22/ 11/ 2012 (الإعلان الدستوري المكمل). وقد جعل هذا الإعلان القرارات الرئاسية نهائية، غير قابلة للطعن من أي جهة، كالمحكمة الدستورية، وذلك منذ تولي محمد مرسي الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد. وبينما أيّد حزب النور (الإسلامي) هذا الإعلان، رأى فيه المجلس الأعلى للقضاء اعتداءً على استقلال القضاء، واستقال عدد من مستشاري الرئيس اعتراضًا على الإعلان، ومنهم من الكتّاب سكينة فؤاد، وفاروق جويدة، وعصمت سيف الدولة. كما وصفت عشرات المنظمات الإعلان في بيان نشر في 24/ 11/ 2012 بأنه “يمنح مرسي سلطات إلهية، ويوجه ضربة قاضية لاستقلال القضاء”، ونشر هذا البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
في الدساتير السورية المؤقتة
مع صاحب الانقلاب العسكري الأول حسني الزعيم كانت البداية، وهو الكردي كرئيس وزرائه حسين البرازي. الزعيم أصر في 7/ 4/ 1949، أي بعد أسبوع من استيلائه على الحكم، على تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، ملغيًا دستور عام 1930. وممن عارضوا مشروع الدستور الجديد وزير المعارف في حكومة حسني الزعيم: ميشيل عفلق، رئيس حزب البعث العربي (قبل أن يصبح حزب البعث العربي الاشتراكي). ودعا عفلق إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. وفي 25/ 6/ 1949 جرى استفتاء على الزعيم رئيسًا. وضم الاستفتاء السؤال عن تخويل الرئيس بوضع الدستور جديد خلال أربعة أشهر، وعن تخويله بإصدار المراسيم التشريعية ريثما يصدر دستور جديد. وقد قال رئيس اللجنة المكلفة بوضع الدستور، أسعد الكوراني، إن الدستور يتبنّى ميثاق حقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة قبل سنة (1948). لكن الرئيس لم يصدر الدستور، بل اكتفى بلجنة قانونية أصدرت قانونًا مدنيًا هو ــ كما كتب طالب الدغيم ــ مزيج دستوري من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي العلماني.
بعد خمسين يومًا من قانون ــ دستور حسني الزعيم انقلب عليه سامي الحناوي في 14/ 8/ 1949. وبعد انتخاب الجمعية التأسيسية إثر الانقلاب العسكري الثاني قدمت الحكومة مشروع دستور مؤقت ــ أي إعلان دستوري ــ وفي هذا المؤقت جاء منح المرأة المتعلمة حق الانتخاب. وبينما كان على الجمعية أن تضع الدستور الدائم خلال ثلاثة أشهر، لم تحدد السبل إذا ما انتهت الشهور الثلاثة قبل إنجاز الدستور الدائم، وهذا ما سنجد له نظيرًا في الإعلان الدستوري 2025.
ويبقى الدستور المؤقت لدولة الوحدة السورية المصرية (الجمهورية العربية المتحدة) الذي صدر في 5/ 3/ 1958 بعد أسبوعين من إعلان الوحدة. وقد أسرعت فيه المادة 2 إلى أمر الجنسية باعتبار الدولة الجديدة هي جماع الجنسيتين السورية والمصرية. وتلامح النظام الرئاسي في المادة 44 من هذا الدستور المؤقت. أما الدساتير المؤقتة التي تواترت بعد الانقلاب العسكري الذي جاء عام 1963 بحزب البعث، من دستور 1964 إلى دستور 1969 فحديث آخر.
من دستور إلى دستور: ما تبقى لنا
سأستعير الآن من غسان كنفاني عنوان روايته “ما تبقى لكم”، لأعنون به ما لعله يخاطب الإعلان الدستوري السوري 2025 من تراثنا الدستوري الزاخر. وأبدأ بدستور المملكة السورية (دستور الملك فيصل)، الذي ترأس هاشم الأتاسي لجنة صياغته. وقد نصت المادة الثالثة منه على حرية المعتقد والأديان، وعلى أن دين الملك الإسلام، من دون ما سيتبع في دساتير قادمة من المصدر، أو مصدر التشريع. وقد دافع الشيخ رشيد رضا عن تحييد الدين عن الدستور سعيًا إلى سحب ذريعة التدخل الأوروبي في شؤون سورية في المستقبل بحجة حماية الأقليات. كما نصت المادة 96 من الدستور على انتخاب أعضاء المحكمة العليا من الهيئات المنسوبين إليه. وجاء في المادة التاسعة: “المواطن السوري هو كل فرد من أهل المملكة السورية العربية، وليس من يتكلم العربية فقط”.
في عام 1928، جرى انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد بعدما أبطل الاستعمار الفرنسي دستور 1920. وقد ترأس إبراهيم هنانو لجنة صياغة الدستور الجديد، وكان (دينامو) اللجنة فوزي الغزي، ولذلك كان له لقب (أبو الدستور)، ولذلك جاء شخصية محورية في روايتي “حجر السرائر” (2010). ومن المعلوم أن هاشم الأتاسي قد حمل من بعد، أيضًا، لقب أبو الدستور، لما كان له من دور في وضع دساتير 1920 ــ 1928 ــ 1949، ولنقل إذًا: “أبو الدساتير”.
عطلت فرنسا دستور 1928 إلى أن أصدره المفوض الفرنسي في 22/ 5/ 1930، ونصت المادة الثالثة فيه على دين رئيس الجمهورية: الإسلام، من دون الإشارة إلى مصدر التشريع. وحددت لرئيس الجمهورية دورة واحدة. كما حددت المادة 68 الحد الأدنى لسن الرئيس بخمسٍ وثلاثين سنة. أما المادة 97 فنصت على انتخاب مجلس النواب (البرلمان، الشعب) ثمانية من أعضاء المحكمة العليا، بينما يكون الأعضاء السبعة الآخرون من الأعلى مرتبة بين القضاة.
وقد تواصل العمل بدستور 1930 إلى أن جرى تعديله عام 1947 كي يكون لرئيس الجمهورية شكري القوتلي دورة ثانية. ويكتب طالب الدغيم نقلًا عن رايسنر أن القوتلي أمر محافظ دمشق بهجت الشهابي، وضباط الأمن المشرفين على صناديق الانتخاب، بالتزوير في الجولة الثانية من الانتخاب، ولما فاز التزوير قاد الإخوان المسلمون المظاهرات في دمشق اعتراضًا.
بعد الانقلاب الثاني الذي قاده سامي الحناوي، جاء ما عُرف بدستور الاستقلال، أو دستور عام 1950، في عهد الرئيس هاشم الأتاسي. وقد عاد هذا الدستور مطلبًا ملحًا بعد 2011، استلهمته لجنة صياغة الإعلان الدستوري 2025، كما جاء في مقدمة الإعلان، مع أن دستور 1950 قلص من سلطات رئيس الجمهورية لصالح السلطة التشريعية.
في المادة الأولى من هذا الدستور أن سورية “جمهورية عربية ديمقراطية نيابية”، ولم يخلُ دستور آخر من كلمة (ديمقراطية) إلا إعلان 2025، مثلما خلا من المادة الثانية من دستور 1950، والتي تنص على سيادة الشعب. أما المادة الثالثة منه، فقد نصت على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام، وعلى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع (المصدر، وليس مصدر). وكان النائب نقولا خانجي، والنائب فائز الخوري، قد اعترضا منذ إعداد دستور 1928 على تحديد دين الرئيس، وعدّا ذلك خرقًا لمبدأ المساواة بين السوريين. ودعا فائز الخوري إلى يوم يُسأل فيه السوري عن دينه فيقول: أنا سوري.
نشط الإخوان المسلمون وجريدتهم “المنار” من أجل المادة الثالثة في دستور 1950، أما أسعد الكوراني فقد فضل شطب عبارة دين رئيس الدولة الإسلام، كي يتاح للمسيحي فارس الخوري أن يترشح للرئاسة. واشترطت المادة 72 في رئيس الجمهورية أن يكون سوريًا منذ عشر سنوات، ولم يُسمح بتجديد الرئاسة إلا بعد 5 سنوات (دورة) من الدورة الأولى. وتحدثت المادة 86 عن مسؤولية الرئيس في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى، وعن محاكمته أمام المحكمة العليا التي خصها الدستور بالمادة 116، فبيّن أن الرئيس يختار أربعة عشر عضوًا لينتخب منهم مجلس النواب سبعة، لكأنه بذلك يترك الباب مواربًا لتدخّل الرئيس في تشكيل المحكمة العليا (أي المحكمة الدستورية)، بينما يشرّع الإعلان الدستوري 2025 الباب للرئيس ليسمي أعضاء المحكمة.
أوقف الانقلاب العسكري الثالث الذي قاده محمد أديب الشيشكلي دستور الاستقلال، وجاء بدستور 1953 الذي تقفّى سلفه في المادة الأولى والثالثة، وفي المادة (7) المتعلقة بالجنسية، حيث أضاف أن تجنيس الأجانب يحدد بقانون تراعى فيه الأعراف والعلاقات الدولية. واشترط دستور 1953 أن يكون رئيس الجمهورية سوريًا بالولادة، وأفرد المادتين 87 و88 لخرقه الدستور والخيانة ومحاكمته أمام المحكمة العليا.
توجه دستور الشيشكلي إلى النظام الرئاسي، وجعل له في المادة 114 أن يسمي رئيس وأعضاء المحكمة العليا، ولكن بناءً على موافقة مجلس النواب.
الإعلان الدستوري 2025
تخلى الإعلان عما جاء في مرجعه الأكبر (دستور 1950) من كلمة (ديمقراطية)، وعن المادة الثانية (السيادة للشعب… لا يجوز لفرد، أو جماعة، ادعاؤها/ تقوم السيادة على مبادئ حكم الشعب بالشعب وللشعب). وفي الإعلان ما هو إنجاز مشهود في ما نص عليه من أن الدولة تكفل التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين. بيد أن السؤال يعجل هنا عن (المكونات). هل تعني الأكراد، والتركمان، والدروز، والإيزيديين، والمسيحيين و…؟ هل هي المكونات الإثنية و/ أم الدينية و/ أو الطائفية؟
في المادة 14 من الإعلان أن الدولة تصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقًا لقانون جديد. أما الدستور/ المرجع (دستور الاستقلال) فقد كان أكثر وضوحًا وتحديدًا، إذ جاء في المادة 18 أن للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غايتها مشروعة، ووسائلها سلمية، وذات نظم ديمقراطية. وترك للقانون أن ينظم طريقة (إخبار) السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.
ما إن صدر الإعلان حتى ترجّعت أصداؤه أعلى فأعلى، بين من يصفق لكل ما تأتي به الإدارة الجديدة، مع قدر من التشنيع على من تسول له نفسه بالسؤال ــ فكيف بالاعتراض ــ وبين من أشهر السؤال، أو الاعتراض، مقدرًا ما يحسب أنه إنجاز. وهذه المادة 43 مثلًا تحظر المحاكم الاستثنائية فيصفق المرء لها. وكذلك هي المادة 48 و49، والمادة الخاصة بالعدالة الانتقالية، ولكن ماذا لو تساءل المرء عن إغناء هذه المادة بآلية اختيارية للتسامح والمصلحة، كما كان في جنوب أفريقيا مثلًا؟
مما يتألق في الإعلان المادة 21 المتعلقة بالمرأة، والمادة 22 المتعلقة بالأطفال، ولكن ماذا عن اللغة الكردية؟ وما هي المادة 23 التي تجيز إخضاع ممارسة الحريات للضوابط التي يتطلبها الأمن، أو حماية الآداب العامة؟ ألا يتسلل القمع إلى مثل هذه العموميات؟
في المادة 52 أن مدة المرحلة الانتقالية خمس سنوات، وأنها تنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقًا له. ماذا لو أقر الدستور الدائم بعد سنة، وجرت انتخابات وفقًا له بعد سنة ونصف السنة؟ هل تنتهي عندئذٍ المرحلة الانتقالية؟ هل تستمر حتى نهاية الخمس سنوات، حتى لو أقر دستور؟ ومن سيقرر الدستور الدائم؟ استفتاء؟
لكن الأهم هو ما ضاق به الإعلان على رحابته من المواد التي تكرس الرئيس قيومًا على السلطتين التشريعية والقضائية. فهو يشكل ثلث مجلس الشعب، واللجنة التي ستنظم انتخاب الثلثين الآخرين، وهو من يشكل المحكمة الدستورية التي كان اسمها في الدساتير الأولى المحكمة العليا. وإذا كان الإعلان يفيض في صلاحيات الرئيس، بدعوى النظام الرئاسي، فهو يغفل ما فصلت فيه الدساتير السابقة عن محاسبة الرئيس.
قد يسرع من يرفع البطاقة الحمراء في وجهي: من أين لروائيّ أن يتطفل على شأن قانوني، أو على إعلان دستوري مؤقت؟ وبالطبع، لن يشفع لي أن أذكّر بأن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، الدكتورة بهية مارديني، هي شاعرة أيضًا.
أيًا يكن، المهم أن يصح مخاض الدستور السوري هذه المرة، بعدما طال كذبه وانتظاره.
ضفة ثالثة
————————————
“أمانة عامة للشؤون السياسية” بسوريا..أول خط دفاع للجم الحريات؟/ أحمد مراد
الثلاثاء 2025/04/01
بين وصفها ببوابة لتنظيم العمل السياسي، وبين من رأى فيها مقدمة لمصادرة الرأي وتحجيم الحريات السياسية ووضعها ضمن إطار تحرك ترعاه السلطة، خلق قرار وزارة الخارجية السورية بتشكيل “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، جدلاً قديماً جداً، يتجدد اليوم على بعد أشهر قليلة جداً من ثورة، قامت أساساً على مبدأ الحرية.
ووصفت وزارة الخارجية السورية “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، بأنها بوابة لتنظيم العمل السياسي، وتمهيد لمرحلة سياسية جديدة، بعد توقيع الإعلان الدستوري، وإعلان تشكيل الحكومة السورية الانتقالية.
صلاحيات “الأمانة”
وجاء القرار رقم 53 الصادر عن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، في 27 آذار/مارس الماضي، بإنشاء كيان جديد ضمن هيكلية الوزارة، بهدف “تعزيز الكفاءة السياسية وتنظيم العمل الرسمي في المرحلة المقبلة”، وفقاً لما ورد في نص القرار.
وحدد القرار المهام الأساسية للأمانة الجديدة، وتشمل الإشراف على النشاطات السياسية الداخلية، والمشاركة في صياغة السياسات العامة، بالإضافة إلى إدارة أصول حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة، وتوظيفها لخدمة الأهداف الوطنية. كما منح القرار الأمانة موازنة مالية مستقلة ضمن موازنة الوزارة، مع خضوعها للرقابة المقررة.
مخاوف قديمة تتجدد
بالمقابل، سادت بين أوساط الناشطين والحقوقيين ردود فعل سلبيةً تجاه القرار، كونه ينطوي على مخالفات قانونية ودستورية، واعتبرته بوابة لمصادرة الحياة السياسية في سوريا وتجاوزاً لحدود المشروعية التي يفترض أن يتقيد بها الوزير، وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة وفق المرسوم رقم 20 لعام 2016، الذي حدد اختصاصات ومهام الوزير واختصاصات ومهام الوزارة.
ويعتبر الحقوقي عبد الرحمن الشيخ علي، أن الوزارة هذا القرار يندرج ضمن مساعي الحكومة السورية لإعادة تنظيم الحياة السياسية، وإنهاء الفوضى السياسية وتنظيم النشاطات الحزبية ضمن إطار قانوني.
ورغم اعتراضه على المخالفات القانونية المحيطة بشكل القرار وصلاحيات لوزارة الخارجية، قال الشيخ علي لـ”المدن”، إن المرحلة الانتقالية تحتاج لهيئة تتولى رسم السياسات بما يساهم في إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، إضافة لتفكيك هيمنة حزب البعث، وإعادة توظيف أصول الأحزاب القديمة ما يحد من استمرار نفوذ البعث في أجهزة الدولة”، معتبراً أن الحياة السياسية في سوريا كانت قائمة على حزب البعث كقائد للدولة والمجتمع، رغم إلغاء المادة الثامنة من الدستور بعد الثورة، لكن السيطرة هذه بقيت متجسد إل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عام 2024، حيث بلغت نسبة أعضاء حزب الرئيس السوري المخلوع، 68% من إجمالي الفائزين بالانتخابات.
وأثار قرار وزارة الخارجية مخاوف جدية من تحول “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، إلى جهاز أمني يقيد حرية العمل السياسي، في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة حرجة على الصعيد السياسي في المقام الأول.
ويقول الباحث أيمن أبو هاشم لـ “المدن”، إن القرار 53 الصادر عن وزير الخارجية السوري، يمثل تقييداً لحرية العمل السياسي الذي كفله الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 آذار /مارس الجاري. وتنص المادة 13 من الإعلان الدستوري على أن “تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”، وكذلك تنص المادة 14 منه على أن “تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقا لقانون جديد، وتضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات”، وبالتالي فإن قرار تشكيل “الأمانة العامة” مخالف فعلياً للإعلان الدستوري ومواده التي كفلت حرية التعبير، والحياة السياسية والأحزاب والنقابات.
ويضيف أبو هاشم أن تشكيل الأمانة العامة في حال ضرورته، يجب أن يكون مرتبطاً بقانون الأحزاب أولاً، ومرتبط بوزارات أخرى كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، باعتباره شأن داخلي ليس ذا صلة بمهام وصلاحيات وزارة الخارجية.
وفيما لم تتضح بعد المدة التي سيصدر فيها قانون الأحزاب وأبرز مواده، منحت وزارة الخارجية، “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، اختصاصات واسعة تخولها الإشراف على عمل الهيئات والنشاطات السياسية، وتلغي التوجه نحو التشاركية السياسية، في مرحلة تفترض العمل على تأكيد هذه المشاركة وتعزيزها ودعمها.
ويؤكد أبو هاشم أن “عدم تحديد القرار حتى لطبيعة تخصص الأمانة العامة، يمنحها سلطات تقديرية واسعة لممارسة دور رقابي على العمل السياسي، وهذا ليس من حقها. فالمطلوب تعزيز إنشاء الأحزاب السياسية في سوريا”. ويقول: “يثفهم من تشكيل الأمانة، النزعة نحو تشكيل حزب السلطة، الذي يسيطر على كل مقاليد العمل السياسي، ويضبط إيقاعه وفقاً لتوجهات ورغبات المسؤولين وأصحاب القرار السياسي”.
رسائل سلبية
ومع احتفاظ الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، اعتبر ناشطون أن هذا القرار يحمل رسائل سلبية، خصوصاً للمهتمين والمنخرطين بالشأن السياسي، ويحمل في طياته “صلاحية” التقييد والتشدد ضد حرية العمل السياسي ويخالف حرية الرأي والتعبير.
وتقول الناشطة النسوية ومديرة منظمة “عدل وتمكين” هبة عز الدين، لـ “المدن”: “أصبح لوزارة الخارجية الآن دور المشرف على جميع الأنشطة السياسية، ومراقبة وتحريك السياسة داخل البلاد، وهذا يعني تقييداً لأي حراك سياسي مستقبلي في سوريا، وتشديداً أكتر على أي حراك لا يتماشى مع توجهات السلطة الحاكمة، وهذا يعيدنا 50 عاماً إلى الوراء عندما أعطى قانون الطوارئ للسلطات الحق بالتدخل بأي نشاط سياسي أو اجتماعي تحت مبرر (حماية الأمن القومي)، هذا ما قيّد الحريات السياسية بشكل كبير”. ولا تغفل “دور الأجهزة الأمنية، كالأمن السياسي والمخابرات، بمراقبة النشاطات السياسية والحزبية، وهو ما قضى، بالمحصلة، على أي حراك سياسي خارج الأطر الرسمية، وأخضعه لعقوبات ضمن قانون العقوبات السوري”.
وتضيف عز الدين أن “إعادة توظيف أصول حزب البعث والأحزاب القومية، يعني وجود نية لدى الحكومة لإعادة هيكلة نفوذ هذه الأحزاب بطريقة جديدة، وهذا سيؤثر حتماً على التوازنات السياسية مستقبلاً”.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر فقط من إعلان “مؤتمر النصر”، في 30 كانون الثاني/يناير 2025، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة، مع تحذير صريح من إعادة تشكيلها بأي صورة، وإعلان الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، أن جميع ممتلكات تلك الأحزاب أصبحت ملكاً للدولة، وتمثل “إرث النظام السابق”.
المدن
—————————
بينما أدوّر في علبة ألوان العيد…أضعتُ الوردي/ نور السيد
الأحد 2025/03/30
كان عيدنا يبدأ منذ العشر الأخير من رمضان. تجهيزات العيد الأولية: تنظيف المنزل وشراء لوازم العيد، لا سيما الملابس الجديدة. بحُكم طبيعة عمل والدي التي غيّبته معظم الوقت، كان عمي يصطحبني مع أولاده إلى الشام نعاين أسواق دمشق، نجوبُ كلِّ سنتمترٍ في شوارعها. تفرّد عمي بميزة لا تتوافر عند أقرانه: صدر رحب للتسوّق. باب توما، الحمرا، الصالحية… وقد يعود ويعجبني شيء في باب توما، لم يكن قد أقنعني في الجولة الأولى، فنعود أدراجنا لنبتاعه… سيراً على الأقدام بالتأكيد. كلّما استنجد أحدنا بعمّي شاكياً توّرم قدميه، قال بهدوء: “المشي رياضة”. ثم نصل شارع بغداد حيث بيت جدي، منهكين تماماً، وفي انتظارنا درج لأربعة طوابق، وهنا قد يبدأ أحدنا بالبكاء فعلاً!
نفرد بضاعتنا ليستحيل البيت سوقاً، ونقيس الجديد طبعاً للمرة الثانية، إذ أن عمي لا يشتري قطعه قبل أن تُقاس وتُعاين بدقّة وكأنه موظف في خط إنتاج التصدير. يعطي التعليمات بشأن تقصير البنطال، وبنفسه قد يضع دبوساً أو اثنين. حين أشكو ضيق حذائي الجلدي الجديد، يقول بأنه سيفرق ويكبر مع الوقت، فأهز برأسي مع شئ من الدلال.. أكتب كل هذا الماضي الجميل وفي الخاطر سؤال: ما الذي بقي من تلك الذكريات لأورثها لأبنائي؟ جعلت الحرب حاجزاً بين الفرح والأعياد، القليل منه كان كافياً ليسعد أطفالنا وبحسرة نقول: “إيييه مساكين وين عيد اليوم من عيد زمان!” لربما هي الحسرة ذاتها التي زفرها أهلنا.
طحين فرخة
ثم يحين شراء لوازم المعمول، من طحين فرخة وزيرو وكندي. كنت أسمع مسميات الطحين الكثيرة وأستغرب. قد يستغرق انتقاء الجوز الجيد والفستق الحلبي، يوماً كاملاً، هكذا كنت أعتلي صهوة الوقت الرمضاني مع عمي، وكان جزئي المفضل ذاك المتعلق بسوق البرزورية، حيث يلمع البنبون والشوكولا والملبّس والفاكهة المجففة، فيخيّل لي أني في مدينة ألعاب تبرق أضواؤها ابتهاجاً بنا. لم أذكر أني اصطحبت ابني يوماً ليواعد العيد هناك قبل أوانه، وأسأل نفسي: لماذا؟ رغم إقامتي في دمشق، والأسواق التي كان عمي يتحمل مشقّة السفر إليها قريبة مني! إذاً هي الروح التي فقدت ألوانها وأبقت على أسودها وأبيضها، فالحرب لم تترك لنا هناءة نسعى إليها.
جوز الهند وقوالب الزبدة والبن غير المحمّص وحبّات الهال والمستكة:”هل نسينا شيئاً؟”، يكرّر عمي. هناك يوم سمّاه “يوم الجوارب”، حينما يعدّ أفراد العائلة الكبيرة مستذكراً معه ألوان ثياب الصغار لاختيار ما يلائم من ألوان. ابتياع كيس ضخم من الجوارب كان من طقوس العيد الذي لم يستغنِ عنها العمّ حتى الآن. وقد وصلتني منه جوارب منذ زمن قريب، فبكيت من دون قصد. ها أنا الصغيرة المتعربشة على حافة عربة الجوارب الضخمة، أنتقي لوني المفضل. غدوتُ أُماً ولم ينسَ العمّ أن يبتاع لي جوارب العيد. أستشعر فرحة طفلي كلّما أرسل له عمّه ثياب العيد، أصدّقها، فقد مرّت طفولتي كلّها تحت مظلّتها الوردية.
الغنائم في أيدينا الصغيرة، نتجه إلى المنزل الكبير منهَكين فرحين مُبشّرين العمّة بكامل لوازم الحلو. كلّ فردٍ من أسرتنا الكبيرة اختصّ بمهمة. العمة تعجن قوالب الزبدة مع السكر المطحون، أقراص الحليب مع توابلها. الغْرَيبة مع مشاقها، تقول العمة: “ضعوها في البراد فأم فلان نصحت بذلك لمنع التشقق”. المعمول بأصوات قوالبه الخشبيه تنثر صوت الفرح في الدارة الكبيرة.
في وقفة العيد، يزداد قلبي الصغير خفقاناً، فالموعد اقترب! تعجن العمة وتخبز على تنور الفناء الخلفي، مساءً تدهن أقراص السمن ويملأ عمي الأصغر جرة الفخّار بحبات الفول، يغطي فوهتها بالعجين والشاش ليبيتها ليلة كاملة في أحضان جمر التنور.
حنّاء وبنبون وورقة نقدية مكوية
حمّام العيد، بعده مباشرة تجهيز سلات البنبون وتذوّق جديد العام: طعم البنفسج، كراميل النسكافيه، الموالح في صحونها المقطعة، الفاكهة على الطبق الكبير بأسلوب فني. نحمل الأطباق متسابقين إلى الصالون. وإذا ما بدأت العمة بجبلِ الحنّاء لأيدينا الصغيرة نسارع إلى شجرة “الفلفل” العملاقة عند مدخل البيت، لينتقي كلٌّ منا ورقته ويبلّل كفّه بالماء ويفرد الورقه فيه منتظراً دوره.
أعيد حساباتي، من أين سأجلب لطفلي كل هذا؟ لعلّي أصطحبه للأسواق، إلا أن أمان العائلة الكبيرة لن يحضر وقد شرذمت الحرب ذوي القربي في كل بقاع الأرض.
كانت بهجة العيد تتوارى في كل شئ، في أكوام الآس، في ترانيم جرن القهوة. وتبقى صورة جدي بالقضاضة البيضاء يحمّص حبات البنّ، هي العيد. ابتسامته وهو يفرغها على الجريدة بعدما اسودّت، هي العيد. الورقة النقدية المكوية الذي يتعمد عمي أن تكون من المصرف لأيادينا، والتي أخشى أن أطويها فتخسر من جمالها.
مَرَق المخلل
جلّ ما أخشاه هو تلك الديمومة في خسران البهجة، “الليلة الكبيرة” كما سمّاها صلاح جاهين، تتماهى في الصغر. فرغم كل ما حملت جعبتي من فرح مكثّف قطّرتُ بعضه هنا، إلا أن لأمي حسراتها لأني لم أعش فرحة أعياد طفولتها. فالمدينة كلّها تتزين ليلة العيد، الثياب وقد استُلمت من الخياطة، المعمول المخبوز في فرن الحيّ الذي نظم دور الصواني، وفي الصباح تتزين تُرب دمشق بالآس الأخضر. تقول أمي أن صديقتها المسيحية كانت ترتدي جديدها أيضاً وتشاركا بهجة العيد، كذلك فعلت أمي، ثم انتبهت أن ضيافتهم تختلف قليلاً عن ضيافة أعياد المسلمين، عندها فقط أدركت بأنهما عيدان مختلفان. أراجيح للصبايا داخل بيوت دمشقية، سيارة مكشوفة “هونداية” تأخذ الأولاد في نزهة قصيرة، مرق المخلل الذي يتهافت الأطفال لشرائه، تضحك أمي وتقول إنها لا تفهم ما الذي يعجبنها ويفرحنا به لهذا الحدّ، وهو مرق مخلل وردي اللون وكفى! كذلك عربة الفول النابت وبوظة بكداش في الحميدية، وكركوز وعيواظ – خيال الظل المنتشر في الحواري، والنوبة.
كانت تلك مسلّمات العيد آنذاك، والأرجح أنها لن تعود. يلعب أطفالنا اليوم بالألعاب النارية، يصوّبون مسدساتهم وبواريدهم البلاستيكية على رؤوس بعضهم البعض ويطلبون الاستسلام. ينتحلون الأبطال. مسلسلات رمضانية بألفاظ ومتلازمات تتبدّل كل عام، وأولادنا يتبنون تسريحات شعر يرونها في التلفزيون، وموضة ألبسة، ثم يجوبون الحواري تائهين يبحثون عن ألوان عيد ولّى ولم يدروا عنه.
المدن
—————————-
لماذا يحتاج ترامب تعاون الشرع؟/ عمر كوش
31/3/2025
يبدو أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحسم بعدُ موقفها من التغيير الحاصل في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، حيث لم تواصل سياسة الانفتاح على الإدارة الجديدة في سوريا، التي بدأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وجسدتها في خطوات عديدة.
حيث كان لافتًا مسارعة الولايات المتحدة إلى التعبير عن ارتياحها لسقوط نظام الأسد البائد، ثم رحب الرئيس الأميركي – في وقتها – جو بايدن بسقوط هذا النظام، وأصدر بعده وزير الخارجية الأميركي السابق بيانًا أعاد فيه تأكيد الولايات المتحدة على دعمها الكامل لعملية انتقال السلطة السياسية بقيادة سورية جديدة.
وأورد شروطًا تحدد طريقة تعامل بلاده مع الإدارة السورية الجديدة، والتي لخصها في احترام حقوق الأقليات، وتسهيل تدفُّق المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين، ومنع استخدام سوريا قاعدة للإرهاب أو محطّ تهديد لجيرانها، وضمان تأمين كافة مخزونات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتدميرها بشكل آمن.
وفي سياق دعم التغيير الحاصل في سوريا، طلبت الخارجية الأميركية من كافة الدول الامتناع عن التدخل الخارجي في شؤون سوريا، وأبدت استعداد واشنطن “لتوفير كامل الدعم المناسب لكافة المجتمعات والدوائر الانتخابية السورية المختلفة”.
ثم أوفدت إدارة بايدن مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، والتقت مع أحمد الشرع في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتزامن ذلك مع إلغاء واشنطن مكافأة القبض على الشرع، التي كانت تقدر بعشرة ملايين دولار، بعد تأكيدها أنه بدا في صورة “رجل عملي”.
ثم اتخذت واشنطن مجموعة من الإجراءات والاستثناءات حول العقوبات المفروضة على سوريا، كان أولها وأبرزها قرار وزارة الخزانة الأميركية في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، القاضي برفع جزئيّ عن العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، وذلك “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
لم تتخذ الإدارة الأميركية السابقة جملة هذه المواقف جزافًا، بل لأن سقوط نظام الأسد البائد حقق لها رغبة كانت تسعى إليها جاهدة، وهي تحجيم نفوذ النظام الإيراني في سوريا، حيث إن إسقاط الأسد، قضى على النفوذ الإيراني كليًا في سوريا، وقطع شريان التواصل ما بين طهران والضاحية الجنوبية في بيروت، ولم تعد سوريا ممرًا للأسلحة الإيرانية إلى حزب الله الإيراني، لذلك من الطبيعي أن تنفتح الولايات المتحدة على الإدارة السورية الجديدة.
بالمقابل، ظهرت مؤشرات متضاربة حول موقف الإدارة الأميركية من الإدارة الجديدة في سوريا، فهناك شخصيات قيادية في الكونغرس الأميركي، ومن الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي، تطالب بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لا سيما العقوبات القطاعية.
فيما أظهر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو موقفًا متشددًا، حين تحدث عن أن “السلطة أصبحت متركّزة بيد شخص واحد، وهذا غير صحي”، وأكد أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في سوريا، ولن تعمل على رفع العقوبات قريبًا.
ثم أعلن في بيان أصدره عن تنديد “الولايات المتحدة بإرهابيين إسلاميين متطرفين، من بينهم متشددون أجانب، قتلوا أشخاصًا في غرب سوريا”، وطالب السلطات المؤقتة في سوريا بمحاسبة مرتكبي المجازر ضد المجتمعات الأقلية في سوريا.
وفي نفس السياق، ذهبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، إلى أن واشنطن ما تزال تراقب تصرفات السلطات الجديدة، والخطوات التي تتخذها، وأنها ستحدد سياستها المستقبلية بناء على ما ستقوم به السلطات المؤقتة من خطوات في عدد من القضايا، وتُواصل في نفس الوقت دعوتها إلى حكومة شاملة بقيادة مدنية في سوريا.
أما مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فقد ربط الموقف الأميركي مع التطبيع الإسرائيلي مع كل لبنان وسوريا. وهو ربط لافت وخطير، كونه يعبر عن كنه السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، التي تأخذ أولًا وقبل أي شيء مصالح إسرائيل وأمن إسرائيل، كما يشي بأن هاجس أمن إسرائيل يشكل أولوية بالنسبة إلى إدارة ترامب، وأنه من الممكن لهذه الإدارة أن تساوم السلطات السورية المؤقتة في مقايضة، تقوم على التطبيع مع إسرائيل، وعقد اتفاقية سلام مذلة معها، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على سوريا.
لذلك ليس صدفة أن يتحدث ويتكوف عن ضرورة ضمان أمن إسرائيل، لأنه يعكس ما تريده بالفعل الولايات المتحدة من السلطات السورية الجديدة بعيدًا عن الشروط المعلنة، والادعاءات المستخدمة لتغطية أهدافها الحقيقية، فالأمر يتعلق بتقديم ضمانات لأمن إسرائيل أولًا وقبل كل شيء، وبما يفضي إلى تجريد سوريا من ممكنات تحوّلها إلى قوة عسكرية مستقبلًا، وهو ما تقوم به إسرائيل عبر عملياتها العسكرية العدوانية، التي لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد البائد، سواء عبر عمليات قصف المواقع والأصول العسكرية للجيش السوري السابق، أو عبر التوغلات المستمرّة واحتلال المنطقة العازلة.
اللافت هو أنَّ الاتفاق الذي وقع مؤخرًا بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية (قسَد) مظلوم عبدي، تمّ بوساطة أميركية شبه علنية، حيث لعب قادة عسكريون أميركيون دورًا هامًا في دفع عبدي للقبول بإدماج كافة المؤسسات العسكرية والمدنية في مناطق شرقي الفرات ضمن الجسد السوري، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
وهو الأمر الذي يعكس وجود تيار في الإدارة الأميركية يدفع باتجاه وحدة الأرض السورية وسيادة الدولة السورية الجديدة على كامل أراضيها، وبما يدعم وحدتها واستقرارها، ويمنح الولايات المتحدة دورًا في تشكيل مستقبلها، في ظل تواتر الحديث عن استعدادات الإدارة الأميركية لسحب قوات بلادها من سوريا.
وبالتالي ترى هذه الإدارة أن أي لعب باستقرار سوريا الجديدة في الوقت الراهن يحمل معه إمكانية عودة النفوذ الإيراني بشكل أو بآخر، وهو ما يعمل على تجنّبه صنّاع القرار في واشنطن، الذين باتوا يتبنون سياسة تدعم ذلك، مقرونة بشروط عديدة لتوجيه عملية الانتقال في سوريا، بشكل يفترق عن سلوك النظام البائد، القائم على القمع ومركزة السلطة، وتسهم في إشراك مختلف المكوّنات الاجتماعية السورية في العملية السياسية الانتقالية.
السؤال الأكبر بالنسبة إلى السوريين، هو استمرار العقوبات الأميركية على سوريا، التي تعيق كلّ الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وتعيق جهود التعافي المبكّر، فضلًا عن إعاقتها تدفق الاستثمارات اللازمة من أجل الشروع في إعادة إعمار ما هدمه نظام الأسد البائد.
ويبدو أنّ البيت الأبيض قد يمضي نحو انفتاح أوسع في العلاقة مع السلطات السورية الانتقالية، ويُفترض أن يشمل ذلك تخفيفًا تدريجيًا للعقوبات الأميركية، لكن الشروط الأميركية المعلنة لرفع العقوبات تشمل تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيماوية، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وعدم تعيين مقاتلين أجانب في مواقع عسكرية قيادية، وذلك في ضوء تعيينات سابقة أثارت قلقًا دوليًا، وشملت مقاتلين إيغورًا وأردنيين وأتراكًا في وزارة الدفاع السورية، إضافة إلى تعيين جهة اتصال سورية لمساعدة الولايات المتحدة في جهودها للعثور على الصحفي الأميركي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن.
المشكلة ليست في الشروط الأميركية المعلنة، وحتى الأوروبية، بل في ممكنات استخدامها كوسيلة ابتزاز للسلطة الجديدة، وليس للتأثير فقط على سير العملية الانتقالية.
وبالتالي فإن ذلك يزيد حجم التحديات التي تواجهها، خاصة أن الإدارة السورية الجديدة، بالرغم من أنها أرسلت العديد من الإشارات الإيجابية، المطمئنة للداخل السوري وللخارج أيضًا، وقدمت صورة تبتعد عن نماذج الحكم الإسلامية المتشددة، فإن ثمة أخطاء ترتكب، حيث ما تزال أغلب مؤسسات الدولة الناشئة تمتلئ إداراتها بلون واحد، وأسهمت أحداث الساحل والانتهاكات في زيادة الارتباك، وفقدان الثقة بين مختلف المكونات الدينية والمذهبية السورية.
كما أن الإعلان الدستوري منح صلاحيات مطلقة للرئيس، وقوبل ذلك بانتقادات داخلية وخارجية واسعة، وبالتالي، فإن المطلوب سوريًا هو تحصين الوضع الداخلي.
لا شك في أن المواقف الأميركية حيال سوريا الجديدة تتصل بالمواقف الإقليمية والدولية، وخاصة المواقف الأوروبية والتفاهمات الأميركية الروسية، خاصة أن سوريا حاضرة بقوة في الاتصالات الأميركية الروسية، التي جرت مؤخرًا.
ولعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرّف على النهج الذي من المتوقع أن تبلوره إدارة الرئيس ترامب قريبًا بخصوص سوريا، وربما بناء عليه بعث برسالته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع في 20 مارس/ آذار الجاري، وأبدى فيها استعداده لانفتاح أكبر على السلطات السورية الجديدة، بما يتوافق مع الرؤية الأميركية الروسية المشتركة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وباحث سوري
الجزيرة
—————————
مشروعا ربط تركيا بسوريا والعراق.. ما فرص تنفيذهما على الأرض؟
ضياء عودة – إسطنبول
01 أبريل 2025
قال وزير النقل والبنية التحتية في تركيا، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده قطعت “مرحلة مهمة” على صعيد مشروعين منفصلين “مهمين”، الأول يمر من العراق والثاني يقطع الحدود مع سوريا وصولا إلى العاصمة دمشق.
ويعرف المشروع الأول بـ”طريق التنمية”، وكان قد تم الإعلان عنه لأول مرة خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تركيا في مارس 2023.
ويسمح هذا المشروع للعراق باستغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وتركيا ثم أوروبا، ناهيك عن إعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد.
أما المشروع الثاني، فقد كشف عنه الوزير التركي حديثا، وقال إنه يقوم على شبكة سكك حديدية تنطلق من منطقة ميدان إكبس الواقعة على الحدود مع تركيا من جهة سوريا (بريف عفرين) باتجاه حلب وبعد ذلك إلى دمشق.
أورال أوغلو أوضح في تصريح له لصحيفة “حرييت”، أنه تم قطع مرحلة مهمة في مشروع “طريق التنمية”، الذي يربط تركيا بميناء الفاو على الخليج، عبر سكة حديد وطريق سريع بطول 1200 كيلومتر.
وأضاف أن السوداني سيزور تركيا في الأيام المقبلة، لبحث التفاصيل النهائية المتعلقة بهذا المشروع.
ورغم عدم تحديد موعد زيارة السوداني بشكل نهائي، فإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يخطط أيضا لزيارة العراق في النصف الأول من العام، وفق أورال أوغلو، الذي توقع حسب صحيفة “حرييت”، أن تكون القرارات التي اتُخذت خلال هذه الزيارات مرتبطةً بالاتفاقيات.
وفي سياق منفصل، صرّح وزير النقل التركي بأنه سيتم إنشاء شبكة سكك حديدية من الحدود مع سوريا إلى دمشق. وقال: “هناك شبكة سكك حديدية ستمتد من ميدان إكبس إلى حلب”.
وتابع: “بينما تم تدميرها لمسافة تتراوح بين 45 و50 كم تقريبا، فإن الجزء الباقي منها لا يزال مفتوحا للوصول إلى دمشق. ونبذل جهودا لإنشاء ذلك أولا”.
وزاد الوزير: “نتحدث هنا على الأرجح عن استثمار يتراوح بين 50 و60 مليون يورو. نبذل جهودا لتمويله وبنائه بطريقة ما”.
وتطمح بغداد إلى تنفيذ مشروع “التنمية” بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية وسوريا، والتي دعي ممثلوها إلى العاصمة العراقية للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع، في نوفمبر من العام الماضي.
وقال السوداني في كلمة بالمؤتمر حينها: “نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة، وإسهاما في جلب جهود التكامل الاقتصادي”.
وعلى صعيد الخط الرابط بين تركيا وسوريا، فقد سبق أن أعربت تركيا عن استعدادها لفتح بوابات التبادل التجاري مع سوريا على مستويات عليا، وجاء ذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وتسلم إدارة أحمد الشرع زمام الحكم في دمشق.
وفي تصريح سابق للوزير أورال أوغلو، فقد أشار قبل شهرين إلى أنه سيتم إصلاح خطي السكك الحديدية بين مدينة الراعي الحدودية وحلب وبين ميدان إكبس الواقع في أقصى الشمال الغربي لسوريا مع مدينة حلب أيضا، والتي تعرف منذ عقود بالعاصمة الاقتصادية لسوريا.
ما فرص تنفيذ المشروعين؟
يقول الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية، محمود علوش، إن “التحوّل الحاصل في سوريا (إثر سقوط نظام الأسد) يجلب فرصا اقتصادية لها ولتركيا وللمنطقة بشكل عام”.
لكن علوش يعتقد في المقابل، بأنه “من المبكر الحديث عن حجم هذه الفرص، لأن الأولوية في الوقت الراهن في سوريا منصبة على تحقيق الاستقرار وتمكين نهوض الدولة من جديد، واستعادة السيطرة والسيادة على كل أراضيها”.
ويضيف لموقع “الحرة”، أن “العامل الأساسي في مثل هذه المشاريع (في إشارة منه إلى خطوط السكك الحديدية والطرقات) هو الأمن. ودون توفر هذا العامل لا يمكن لهذه المشاريع أن تنجح”.
ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن فرص تنفيذ المشاريع في سوريا “تبقى كبيرة”. ويوضح أنها ستكون مكملة لمشروع “طريق التنمية” المار من العراق، من حيث الأهداف المتعلقة بالتكامل الاقتصادي الإقليمي.
“هذه المشاريع في سوريا كما (طريق التنمية) ستعود بفوائد اقتصادية على سوريا وتركيا وعلى جميع الدول التي ستكون جزء من هذا التكامل الاقتصادي”، وفقا للباحث.
ويتابع: “الاتجاه السائد في الشرق الأوسط اليوم هو لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. هذا التكامل هو بوابة كبيرة لتحقيق الرفاهية لشعوب ودول المنطقة، ويعتبر أيضا منطلق تعاون بين دول المنطقة في مجالات تتجاوز المسائل الاقتصادية”.
كما يشدد علوش على أن فكرة أن “الاقتصاد عادة ما يكون بوابة لعلاقات جيدة بين دول المنطقة”.
ما “طريق التنمية”؟
تم الإعلان لأول مرة عن “طريق التنمية” خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا، في مارس 2023، حيث كُشف عنه في مؤتمر صحفي مشترك للسوداني وإردوغان.
وأكد السوداني حينها اتخاذ خطوات جادة تجاه “تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وخاصة المجال الاقتصادي ووضع أسس تعزيز التعاون مع الأشقاء والجيران في هذا المجال الاقتصادي”، حسب تقرير سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأشار إلى أن “مشروع طريق التنمية.. ليس فقط للعراق وتركيا وإنما للمنطقة والعالم، وهو الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة ويربط الشرق بالغرب”، لافتا إلى أن “هذا الممر سينقل البضائع والطاقة”.
كما كشف أن الطريق يتضمن “خطا للسكك الحديدية ينقل البضائع، في المرحلة الأولى بسعة 3.5 مليون طن، ليصل في المرحلة الثانية إلى 7.5 مليون طن. وطريق التنمية (القناة الجافة) سيشتمل على النقل البري وخطوط نقل الطاقة، فضلا عن ميناء الفاو”.
تمهيد سابق في سوريا
وسبق أن أعلن وزير النقل التركي في 24 ديسمبر 2024 (أي بعد أسبوعين من سقوط نظام الأسد)، أن بلاده ستقوم بتنفيذ خطة من 5 مراحل، للمساعدة على إعادة إعمار سوريا، تتضمن إصلاح وتأهيل منشآت النقل البرية والبحرية، بالإضافة إلى المطارات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أوغلو قوله، حينها، إنه تم إنجاز تقييم لحالة مطاري حلب ودمشق، بقصد إعادة تأهيلهما، بمساعدة مباشرة من الإدارة العامة للمطارات التركية.
وتتضمن الخطة كذلك إعادة تشغيل خطوط السكة الحديدية المتجهة إلى العاصمة السورية دمشق، التي كان بعضها جزءا من خط سكة حديد الحجاز الشهير.
تعتبر تركيا من أبرز داعمي الإدارة الجديدة في سوريا.
ودخل ذلك الخط الشهير الخدمة عام 1908، وكان يمثل السكة الحديدية الوحيدة التي تم إنشاؤها في المنطقة تحت سلطة الدولة العثمانية.
سكة حديد الحجاز وفرت عند إنشائها ربط إسطنبول بالمدينة المنورة، عبر دمشق، مع وجود خط إضافي نحو مدينة حيفا، تمتد فروعه إلى كل من عكا ونابلس.
الخطوط المزمع إعادة إحيائها ستربط تركيا بسوريا عبر شبكة سكة حديدية وطرقات سريعة، بحسب تصريح الوزير التركي.
إعلان أوغلو أن العمل على إعادة إعمار سوريا تضمن كذلك في ديسمبر 2024، إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة، ضمن إطار ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، وهو ما قوبل بمعارضة يونانية، آنذاك، حيث اعتبرت أن الحكومة السورية الحالية “مؤقتة”، وبالتالي لا يمكن أن تقوم بتوقيع معاهدات من ذلك القبيل.
ضياء عودة
————————-
تحديات تتعلق بالتصميم والسيادة وقيمة الليرة/ أمير حقوق
طباعة العملة السورية في أوروبا.. ملف على الطاولة
تحديث 01 نيسان 2025
قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، ميخائيل أونماخت، لعنب بلدي، في 16 من آذار الحالي، إن العملة السورية ستتم طباعتها في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي علّق عقوبات على عدة قطاعات، كالنقل والطاقة والتبادل المالي بين البنك المركزي والبنوك الرسمية الأخرى، ما سيعطي فرصًا إضافية للتعاون الاقتصادي.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي، في 24 من شباط الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، التي فرضت على دمشق خلال حكم رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.
كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات، هي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
عنب بلدي تواصلت مع مصرف سوريا المركزي، للحصول على رد رسمي حول توجه سوريا لطباعة عملتها المحلية في أوروبا، وشكل الاتفاقية الممكن انعقادها، ولكن لم تحصل على أي رد.
واقع العملة السورية يعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ويعتبر موضوعًا مهمًا للنقاش حول الحلول الاقتصادية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد السوري واستقرار العملة.
عنب بلدي فتحت ملف “طباعة العملة السورية في أوروبا”، لقراءة الأثر الاقتصادي وأبرز الانعكاسات والشروط الواجب توفرها.
عقود الطباعة نُفذت في روسيا
تسلمت سوريا شحنة جديدة من عملتها المحلية المطبوعة في روسيا، في 5 من آذار الحالي، ومن المتوقع وصول المزيد من الشحنات في المستقبل، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
التعاقد على طباعة العملة السورية كان موقعًا منذ عدة سنوات قبل 8 من كانون أول 2024، ما بين روسيا والنظام السابق، وهذا ما يفسر تأخر السلطة الحالية عن طباعة عملة جديدة، باعتبار أن روسيا كان لديها بقية المخزون المتعاقد عليه من فئة 5 آلاف ليرة، التي تم توريدها مؤخرًا.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” الدكتور عابد فضلية، ذكر أن الطبعة الأخيرة التي وصلت منذ بضعة أسابيع، قيل إنها طبعت في إيران، وهو أمر غير صحيح.
وتابع فضلية لعنب بلدي، أن التعاقد على طبعها كان موقعًا منذ عدة سنوات قبل 8 من كانون الأول 2024، ما بين روسيا والنظام السابق، وهذا ما يفسر تأخر السلطة الحالية عن طباعة عملة جديدة، باعتبار أن روسيا كان لديها بقية المخزون المتعاقد عليه من فئة 5 آلاف ليرة، التي تم توريدها مؤخرًا.
وأكد أن جميع عقود الطباعة تم تنفيذها في روسيا، لأن الطباعة في أي دولة أوروبية أخرى لم يكن ممكنًا، بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا، التي يعود تطبيقها في الحقيقة إلى عدة عقود سابقة لعقوبات “قيصر”.
عمليات الطباعة المستقبلية ستكون على الأغلب في إحدى الدول الأوروبية، ويتوقع أن تكون النمسا، بحسب فضلية، بناء على ما ذكره القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في سوريا، وكأنه يقول، توجد مفاوضات بشأن ذلك.
وفي 14 من شباط الماضي، وصلت أول شحنة أموال سورية من روسيا إلى مطار “دمشق”، دون أن يعلن المصرف عن كميتها أو مصدرها هل هي ناتجة عن عملية طباعة أم أنها أموال مصادَرة.
تصميم العملة الجديدة
دراسة شكل وتصميم العملة المطبوعة مهمة جدًا لأسباب متعددة، تشمل الأمان والرؤية الثقافية والهوية الوطنية والتأثير الاقتصادي، كما أن التصميم الجيد للعملة ليس مجرد مسألة جمالية، بل يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار والثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلد.
ويرى الدكتور عابد فضلية أن طباعة الأوراق النقدية الجديدة صار اليوم أمرًا ضروريًا، أكثر من أي وقت مضى، ولا شك أن الحكومة الحالية تعرف ذلك، وتريد ذلك، إلا أن ما يجعل هذا الأمر صعبًا هو أن الأوراق النقدية الجديدة بجميع فئاتها لن تكون نسخة طبق الأصل عن الأوراق المستخدمة حاليًا، بل تتطلب تغيير الصور والكتابات الظاهرة على وجهي الورقة، لتكون شكلًا جديدًا مطورًا مختلفًا.
وأشار إلى أن شكل العملة السورية المطبوعة يجب أن يعكس وجه سوريا اليوم، فهي ليست مجرد ورقة تستخدم في الدفع والشراء، بل تعد وثيقة وطنية افتراضية.
وذكر أن التصميم هو من أصعب الخطوات في التعاقد بين سوريا وأي بلد، لكن، وبعد إتمام عملية الطباعة الأولى، تصبح عمليات الطباعة التالية سهلة وسريعة وأقل تكلفة.
ويتصور فضلية أن من أهم ما يجب أن تتميز به العملة الورقية هو:
أن تكون متقنة التصميم بحيث تكون صعبة أو مستحيلة التزوير.
أن تكون متينة، غير قابلة للاهتراء بسهولة، ولا يتلفها الماء.
تبعات وظروف الطباعة في أوروبا
طباعة العملة تحتاج إلى تكنولوجيا غير متوفرة في سوريا الآن، واستقطابها يحتاج إلى وقت طويل، بحسب الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي.
ويرى قضيماتي أن سوريا اليوم إذ لم يصلها دعم مخصص لطباعة العملة، فهي لا تستطيع طباعة عملتها داخليًا، باعتبار ذلك مكلفًا، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن طباعتها في الخارج له تبعات مستقبلية.
قد توفر طباعة العملة السورية في أوروبا بعض الفوائد المتعلقة بالجودة والثقة، إلا أنه يتعين أيضًا مراعاة التحديات الكبيرة المرتبطة بالسيادة الوطنية والسياسات الاقتصادية والعقوبات.
ويتطلب أي نوع من هذا التعاون دراسة شاملة واستراتيجية، خاصة بالسياسات الاقتصادية المالية، للنظر في جميع العوامل المؤثرة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي، أن أهم دوافع طباعة العملة السورية في أوروبا هو ندرة الخبرات الكافية لطباعة العملة محليًا، ونقص آلات الطباعة ومعداتها في سوريا.
ولكن تحديد جهة الطباعة يتم عبر دراسة العروض المقدمة ودراسة مواقف كل دولة سياسيًا، وفق رأيه.
وتابع أن الطباعة الخارجية أمر حتمي لوقت معيّن، باعتبار سوريا خارج المنظومة المالية العالمية، على أن يترافق ذلك مع تقديم دراسات مشتركة من قبل الدولة السورية والدولة التي تطبع عملتها، حتى تتوفر دراسة موحدة للجهتين لتقديم الخدمة بشكل صحيح، وطرح كميات محددة من العملة، وهي حالة إسعافية.
وأضاف أن الدول الأوروبية لديها خبرة كبيرة بطباعة العملة، وهي تطبع عملتها داخليًا، وهذه الخبرة تعد أساسية وضرورية تفيد ملف طباعة العملة السورية.
وطباعة العملة المحلية داخليًا تعد خطوة استراتيجية تعزز من السيادة الوطنية، وتدعم الاقتصاد، وتحسن من مستوى الأمان والثقة في العملة.
كما تسهم في تطوير الهوية الثقافية وتعزيز الاستقلال المالي، ما يجعلها عنصرًا حيويًا في استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.
شكل الاتفاقية
لا شك أن طباعة العملة المحلية لسوريا خارج البلد تتطلب وضع اتفاقية مبنية على دراسة متأنية واعتبارات استراتيجيات متعددة، فالتعاون بين سوريا والبلد الطابع لعملتها، هو عنصر أساسي لنجاح العملية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مع التأكيد على الأمان والجودة.
وقال الخبير قضيماتي لعنب بلدي، إن طباعة العملة خارج سوريا ينبغي أن يكون ضمن شروط، أهمها ألا يستخدم هذا الملف كورقة ضغط على الحكومات المتلاحقة في سوريا، وثانيًا تكلفة طباعتها، وكذلك الجودة ودرجة صعوبة التزوير والتلاعب فيها، وهي شروط توضع موضع اهتمام للوصول لاتفاقية صحيحة.
الخبير قضيماتي استبعد أن تكون هناك اتفاقيات جرى توقيعها بخصوص طباعة العملة السورية في الخارج، والسبب أن ذلك يتطلب نوعًا من الاستقرار للاقتصاد السوري، ومعرفة القيمة الحقيقية للعملة السورية لبدء طباعتها، وخلال هذه الفترة التي ربما تستغرق سنة أو أكثر، تدرس العروض التي تقدم من عدة دول، وهذه الحيثية تترك للقائمين على المصرف المركزي ووزارة المالية.
وتابع أنه يجب أن تتضمن الاتفاقية شروطًا أساسية يتم الاتفاق عليها من قبل الجانبين، لأن الأمر يتعلق باقتصاد دولة ناشئة، فأي خلل بطباعة العملة وتوريدها لسوريا، وحتى حجم الطباعة يولد مشكلات اقتصادية بالمستقبل، لذلك فإن الشروط والبنود يجب أن تدرس بطريقة صحيحة.
من جانبه، يرى الدكتور عابد فضلية أن العقد المبرم لطباعة العملة الورقية، هو عقد ذو بعد وطني لمن سيستلم العملة، وتجاري بالنسبة لمن يُكلف بالطباعة.
فئات العملة.. بين مؤيد ومعارض
حول تغيير فئات العملة السورية المطبوعة، يختلف الخبراء بين مؤيد ومعارض لإصدار فئات أكبر من المتداولة حاليًا.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” الدكتور عابد فضلية، يعتقد أن الحكومة السورية السابقة لم تراعِ أمرًا مهمًا، وهو ضرورة طبع فئات أكبر من فئة الـ5 آلاف ليرة، إذ إن مشكلة تدني قيمة الفئة الكبرى تكمن في أن المواطن يضطر لاستخدام الكثير من الأوراق لتسديد ثمن أشياء عادية، فيتسارع تلف العملة.
الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي لديه رأي مختلف، فالعملة السورية المتداولة اليوم تفي إلى درجة معينة بالغرض، ويمكن الحفاظ على شكل العملة حاليًا والفئات خلال فترة معيّنة، وطباعة عملة جديدة بفئات جديدة، ولا أحد ينصح بطباعة فئات كبيرة كفئة الـ10 آلاف ليرة لأن ذلك يزيد من حالة التضخم.
ويجب عند طباعة عملة أن يسحب مقابلها كمية من النقد، ويتم استقطاب الفئات المتبقية من روسيا من القطع السوري، ويتم تداولها، والنظام السابق كان يصدر فئات كبيرة دون دراسات وبيانات، وهذا يلعب دروًا مهمًا في تحديد قيمة العملة، لذلك يحتاج إلى دراسات وزارة المالية لإصلاح الخلل.
وكان مصرف سوريا المركزي طرح الفئة النقدية الجديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة، ليتم تداولها جنبًا إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حاليًا منذ 24 من كانون الثاني 2021.
وخلال الفترة الماضية، اعتمد مصرف سوريا المركزي على سياسة حبس السيولة، وحقق ذلك ارتفاعًا “وهميًا” في قيمة الليرة، وهي سياسة تفضي إلى نقص النقد المتاح في الأسواق، سواء كان في أيدي الأفراد أو الشركات أو حتى البنوك.
تاريخ طباعة العملة السورية
حتى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، لم تكن العملة الورقية السورية مستقلة عن العملة الورقية اللبنانية، حيث كان البلدان يستخدمان نفس العملة، وكانت تُطبع هذه العملة المشتركة في فرنسا كامتداد لفترة الاحتلال الفرنسي، وفق ما قاله الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” الدكتور عابد فضلية.
وأضاف فضلية أنه بعد أن انفصلت العملتان، صارت سوريا تطبع عملتها في الدول الأوروبية، ومنها النمسا وسويسرا، وبعد عام 1970، صارت عملة سوريا تُطبع غالبًا في الاتحاد السوفييتي، ولاحقًا في روسيا، وما زالت تُطبع هناك حتى الآن.
عنب بلدي
—————————–
النفط والغاز.. يتدفقان ببطء إلى سوريا/ حسن إبراهيم | هاني كرزي | حسام المحمود | موفق الخوجة
بدأت ملامح تنشيط قطاع النفط والغاز ترتسم ببطء في سوريا، بعد شلل شبه تام استمر 14 عامًا لأبرز حوامل وركائز الاقتصاد السوري، إذ يرى خبراء ومتخصصون أن القطاع يمثل ثروة هائلة تؤهله للعب دور حاسم في تعافي الاقتصاد، لكن هناك عقبات جمّة تعترضه داخلية وخارجية يجب العمل عليها.
بعد سقوط النظام السوري السابق، وتولي حكومة دمشق المؤقتة دفة الحكم، تحرك القطاع عبر واردات روسية من البحر، واتفاقية قيد التنفيذ مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المسيطرة على حقول النفط شرقي سوريا، وفتح الحكومة الباب أمام مناقصات لتوريد النفط ومشتقاته، مع دعم عربي في هذا القطاع.
في هذا الملف، تسلط عنب بلدي الضوء على قطاع النفط والغاز، وملامح نشاطه وطبيعة الخطوات التي اتخذتها حكومة دمشق المؤقتة، وتناقش مع خبراء ومتخصصين أثر هذه التحركات على القطاع وعلى دورها في التعافي وانتشال الاقتصاد السوري من أزماته.
حراك لتنشيط قطاع متهالك
أنهكت سنوات الحرب منشآت قطاع النفط والغاز، وطالتها عمليات التخريب والسرقة وتهالكت بنيتها، وفاقمها الاستخراج والتكرير البدائي، وقُدرت قيمة الأضرار المعلن عنها بـ115.2 مليار دولار أمريكي، منذ 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.
بينما كان إنتاج البلاد 385 ألف برميل نفط يوميًا عام 2010، انخفض بشكل حاد إلى ما بين 24 ألفًا و34 ألف برميل يوميًا فقط بين عامي 2014 و2019، وعاد لينتج حاليًا ما يقارب 110 آلاف برميل، موزعة على 100 ألف برميل من حقول تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و10 آلاف برميل من حقول تسيطر عليها الإدارة السورية الجديدة.
أما الغاز السوري فتراجع إنتاجه من 30 مليون متر مكعب يوميًا عام 2010 إلى ما يقارب 9.1 مليون متر مكعب يوميًا، موزعة على 8 ملايين متر مكعب من الحقول والآبار التي تسيطر عليها الإدارة السورية الجديدة في دمشق، و1.1 مليون متر مكعب من الحقول والآبار التي تسيطر عليها “قسد”، ولا يغطي هذا الإنتاج مجتمعًا سوى نصف احتياج محطات توليد الكهرباء عبر العنفات الغازية البالغ حوالي 18 مليون متر مكعب يوميًا.
خلال السنوات الماضية، كانت إيران تزود النظام السوري بالنفط الخام، ولم تنقطع توريداتها بحرًا عبر المواني السورية أو برًا عبر الأراضي العراقية، وبكميات غير ثابتة أو محددة، بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميًا، وتوقفت في بعض الفترات كنوع من الضغط على بشار الأسد في ملفات أخرى.
فور سقوط النظام، وهروب بشار الأسد إلى موسكو، توقفت طهران عن توريد النفط إلى سوريا، وأبلغت الإدارة السورية الجديدة بأنها مدينة لها بما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار أمريكي، مقابل إمدادات الوقود وغيرها من المساعدات خلال فترة حكم الأسد.
ولا توجد رغبة سورية بإيفاء هذه الديون، مع ردود غير رسمية بأن إيران مدينة لسوريا بمبلغ 300 مليار دولار أمريكي، كتعويضات للشعب السوري والدولة السورية، عما سببته سياسات طهران “الإجرامية والتعسفية” من ضرر للسوريين والبنية التحتية خلال انحيازها عسكريًا مع ميليشياتها لمصلحة نظام بشار الأسد.
تخفيف ورفع عقوبات
بدأ القطاع يستعيد أنفاسه خاصة بعد رفع وتخفيف العقوبات الدولية عن سوريا، والتي استهدفت قطاعات رئيسة من الاقتصاد السوري أبرزها القطاع النفطي، وكانت تهدف لتعطيل أنشطة النظام السوري السابق وخفض إيراداته، وتقييد قدرة الأسد على تمويل القمع.
وعلّق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات، بما فيها المفروضة على قطاع الطاقة، كما رفعت الحكومة البريطانية عقوبات مفروضة على 24 كيانًا سوريًا، شملت عددًا من البنوك وشركات النفط، من بينها “الفرات” و”دير الزور” و”إيبلا” و”الشركة العامة للنفط” وشركة “محروقات” و”الشركة السورية لنقل النفط “و”الشركة السورية للنفط” و”الشركة العامة لمصفاة حمص” وشركة “مصفاة بانياس”.
كما خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات، وأصدرت الترخيص العام رقم “24” (GL24)، الذي أتاح المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 من كانون الأول 2024، والمعاملات لدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها.
ويستمر هذا الترخيص لمدة ستة أشهر مع استمرار حكومة الولايات المتحدة في مراقبة الوضع المتطور على الأرض، وإمكانية تجديده بعد ستة أشهر، وفق تصريح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لعنب بلدي.
العقوبات كانت سببًا لإجبار 11 شركة دولية مسؤولة عن 49.6% من إجمالي إنتاج النفط الخام السوري عام 2010، على التخلي عن عملياتها.
آبار شرقي سوريا..
بانتظار الحكومة
تتركز معظم منابع وحقول النفط السوري في مناطق شمال شرقي سوريا حيث تسيطر “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتمتلك نحو 90% من إنتاج سوريا من النفط، و45% من الغاز الطبيعي، وتعد المنطقة سلة الخبز والنفط للبلاد.
أحكمت “قسد” سيطرتها على حقول النفط بعد معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” بدعم ومشاركة من التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، وخفّ الإنتاج بسبب سوء التعامل وقلة الخبرات وبدائية المعدات التي استخدمتها في استخراج وتكرير النفط.
وكانت “قسد” تصرّف النفط الذي تستخرجه إلى أربعة اتجاهات، الأول الاستهلاك الداخلي، والثاني إلى إقليم كردستان العراق، والثالث إلى مناطق سيطرة المعارضة، والرابع، وهو القسم الأكبر، يصدر إلى مناطق سيطرة النظام السوري السابق، عبر اتفاقيات ووسطاء.
اتفاق قيد التنفيذ
بعد سقوط النظام، اتجهت حكومة دمشق المؤقتة إلى عقد اتفاق مع “قسد”، لاستجرار النفط والغاز من شمال شرقي سوريا، أعلن عنه في 22 من شباط الماضي، وهو امتداد لتفاهمات سابقة بين النظام السابق و”قسد”، مع مراجعة كاملة للعقد بما يتناسب مع “القوانين الوطنية” واحتياجات السوق المحلية، وفق تصريح لمسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة دمشق المؤقتة، أحمد سليمان.
مدة الاتفاق لاستجرار النفط كانت ثلاثة أشهر، وبلغت الكمية المستوردة من “قسد” أكثر من 15 ألف برميل يوميًا من النفط، إضافة إلى كميات من الغاز الطبيعي تتراوح ما بين 500 ألف ومليون متر مكعب.
عقب أسبوعين، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، اتفاقًا وصف بـ”التاريخي”، نص بند منه على دمج جميع المؤسسات العسكرية والمدنية لـ”قسد” ضمن الدولة السورية، بما فيها حقول النفط والغاز.
بعد الاتفاقية، أعلنت وزارة النفط البدء بنقاش آلية التسلم والإشراف على حقول وآبار النفط في شمال شرقي سوريا، واعتزام تشكيل لجان متخصصة للإشراف على تسلم الحقول والآبار، وإعداد تقارير شاملة حول جاهزيتها وحالتها الفنية.
في المقابل، نفى قيادي في “الإدارة الذاتية” تسليم آبار النفط للحكومة السورية، وأكد أن العمل لا يزال جاريًا على تشكيل اللجان المعنية بملفات التفاوض مع دمشق، مشددًا على أن أي اتفاق بهذا الشأن لم يُنفَّذ حتى الآن.
خطوة أولية “غير كافية”
تمثّل الاتفاقيات بين “قسد” وحكومة دمشق، منتصف شباط الماضي، والكميات المتفق عليها، خطوة أولية للتعاون بين الطرفين، وتمهيدًا لعودة الآبار إلى سلطة الدولة وفق تفاهمات بين الجانبين، بحسب الباحث الاقتصادي في “مركز عمران للدراسات” مناف قومان.
ويرى قومان، في حديث لعنب بلدي، أن الكميات المذكورة في الاتفاق لا تلبي سوى القليل من احتياجات سوريا، وغير كافية لإنعاش قطاع الكهرباء أو سد النقص في المحروقات، فحاجة سوريا أكبر بكثير من الكميات المطروحة في الإعلان.
وأوضح الباحث أن سوريا تحتاج إلى حوالي 150 ألف برميل نفط يوميًا، لافتًا إلى أن المتوفر منها حاليًا بالكاد يصل إلى 25 ألف برميل، كما تحتاج سوريا إلى نحو 23 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، والمتوفر منها حاليًا نحو 6.5 مليون متر مكعب.
ويتوقف تسليم آبار النفط والغاز من “قسد” للحكومة على اللجان الفرعية التي يجري العمل عليها بين الجانبين، وفق قومان، معتبرًا أن تسلم الحكومة إدارة الآبار وتدفق النفط والغاز، يخفف من حدة أزمة الطاقة مع تحسين في ساعات الكهرباء وتوفر المحروقات.
وبحسب قومان، قد ترتفع القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى حوالي 2000 ميغاواط مقارنة بأقل من 1500 ميغاواط حاليًا، وهو ما يقلل من التقنين.
مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، كرم شعار، اعتبر أن ما يحدث حاليًا هو إعلان عن السماح لمناطق سيطرة الحكومة الحالية بالوصول إلى نفط وغاز أكثر.
وقال شعار، لعنب بلدي، إنه حتى الآن لا يوجد أي تغيير في مقدرة سوريا على الإنتاج، أو مقدرة الحكومة السورية على الوصول إلى حقول جديدة.
تواصلت عنب بلدي للاستفسار من مسؤول العلاقات العامة لدى وزارة النفط حول الاتفاقية، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا حتى لحظة تحرير الملف.
النفط الروسي..
بادرة حسن نية
الباب الثاني لتنشيط قطاع النفط كان عبر روسيا، فبعد الإطاحة بالنظام السابق، استقبلت المواني السورية عدة ناقلات نفط روسية، أولاها في 20 من آذار، تحمل على متنها حوالي 100 ألف طن من النفط الخام، وصلت إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.
وفي 25 من آذار، وصلت باخرة ثانية إلى مدينة بانياس، تحمل كذلك 100 ألف طن من النفط الخام، قادمة من روسيا.
ومن المتوقع وصول ناقلة روسية ثالثة، في 3 من نيسان المقبل، وفق وكالة “رويترز”.
وصول شحنات النفط الروسية أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا، وما تريده مقابل إرسال شحنات النفط إلى سوريا، خاصة أن موسكو لعبت خلال السنوات الدور الأكبر في تعويم الأسد سياسيًا، ومحاولة إعادة تأهيله على المستوى الإقليمي والدولي، وعسكريًا بقتل السوريين وتغيير دفة المعارك.
الباحث في الشأن الروسي الدكتور محمود الحمزة، يرى أن من المرجح ألا تطالب روسيا الحكومة السورية الآن بدفع قيمة الكميات من النفط التي أرسلتها، لأنها لا تمثل قيمة تجارية كبيرة بالنسبة لروسيا، ويعتقد أن غرض موسكو من إرسال النفط، هو بمثابة بادرة حسن نية لتحسين العلاقات مع سوريا.
وأضاف الحمزة لعنب بلدي أن موسكو تريد أن تلطف الأجواء مع دمشق لتأمين بقائها في الشرق الأوسط، عبر تأمين قواعدها العسكرية على الساحل السوري، كما يعتقد أن الملف السوري حاضر في المفاوضات الأمريكية- الروسية الأخيرة التي تجري بشأن أوكرانيا، وأمريكا تساعد في تحسين العلاقة بين سوريا وروسيا من أجل ضمان أمن إسرائيل.
ثلاثة سيناريوهات لتسديد ثمن النفط
الحكومة السورية لم تكشف عن آلية تسديد ثمن شحنات النفط التي وصلت من روسيا، كما لم تكشف الأخيرة أي تفاصيل عن ذلك.
الباحث في الشأن الاقتصادي يونس الكريم، قال لعنب بلدي، إن هناك ثلاثة سيناريوهات فقط حول كيفية تسديد الحكومة السورية تكاليف استيراد النفط من روسيا.
السيناريو الأول، أن يتم تسديد ثمن النفط مقابل حصص من الفوسفات لروسيا، وهذا وارد جدًا وطبقه النظام السابق، حيث كان يدفع جزءًا من ديونه وخاصة لإيران مقابل منح تلك الحصص، لكن منذ سقوط بشار الأسد، “لم نعد نعلم ماذا حدث بالفوسفات، وما حصص الحكومة السورية، وكم تحصل روسيا على فوسفات، لذلك من المرجح أن يتم دفع الفوسفات لروسيا مقابل استيراد النفط منها”.
وتعلن وزارة النفط في حكومة دمشق المؤقتة بشكل متكرر عن مناقصات للاستثمار في قطاع الفوسفات، الذي يمثل ثروة سورية تصل احتياطياتها في أغلب التقديرات إلى 1.8 مليار طن.
وفي 12 من شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط السورية عن مزايدة لبيع 175 ألف طن فوسفات رطب من مناجم الفوسفات بتدمر، فيما تبدي دول كثيرة اهتمامها بالفوسفات السوري، بعدما سيطرت روسيا عبر عقود مع النظام السابق على جزء كبير من هذا القطاع.
السيناريو الثاني الذي اتبعه النظام السابق، هو استيراد النفط عبر رجال أعمال مرتبطين به، وبالتالي يمكن أن تطبّق الحكومة السورية ذات السيناريو، بحيث تستورد النفط من روسيا، بالاعتماد على بعض أولئك التجار الذين بدأوا بتوطيد علاقاتهم مع دمشق.
يونس الكريم ضرب مثالًا على هذا السيناريو، بأن حكومة “الإنقاذ” التي عملت في إدلب، كانت تعتمد على شركة “وتد” في استيراد النفط، وبالتالي يمكن أن تكون “وتد” قد قامت بعمليات الاستيراد من موسكو، ومن ثم بيعها لوزارة النفط السورية، التي تقوم بدورها ببيعها إلى القطاع الخاص، وتحصيل الأموال ومن ثم إعادة تحويل الأموال إلى الدولار.
السيناريو الثالث بأن تسدد قيمة المحروقات مباشرة من قبل وزارة النفط، فانخفاض سعر الدولار وحبس السيولة النقدية، أسهم في ترميم جزئي للاحتياطي من القطع الأجنبي، إضافة إلى الاستفادة من أموال المساعدات التي منحت للحكومة السورية، والتي استخدمتها بمحاولة تحسين واقع الطاقة بسوريا.
مناقصات للتوريد
عقب سقوط النظام السوري، أعلنت وزارة النفط عن عدة مناقصات لتوريد النفط الخام إلى سوريا، في وقت تعاني فيه الحكومة السورية من تأمين المحروقات عبر موردين دوليين بشكل مستمر يؤمن حاجة سوريا.
أحدث المناقصات كانت في 27 من آذار الحالي، إذ قالت وزارة النفط إنها تجري المناقصة بالنيابة عن شركة مصفاة “بانياس”، داعية لتقديم عروض لتوريد نفط خام خفيف بكمية تعادل سبعة ملايين برميل نفط بخيار البائع.
وفق الإعلان، يمكن أن تزداد الكمية التعاقدية باتفاق متبادل بين الطرفين، ويجب على البائع توريد الكميات وفق مواصفات ذكرها إعلان المناقصة بالتفصيل.
وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، قال خلال لقاء صحفي، إن استيراد مواد المحروقات سيكون متاحًا لجميع الجهات الدولية والشركات والدول، دون حصر استيرادها بالحكومة فقط، موضحًا أن حكومة دمشق بدأت بالتعامل مع القطاع الخاص في هذا السياق.
في تصريح خاص لعنب بلدي، قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط السورية، أحمد سليمان، إن مصادر الناقلات النفطية الواصلة إلى سوريا متنوعة، وهي تنفيذ للمناقصات التي أعلنت عنها وزارة النفط لاستيراد النفط الخام الخفيف والثقيل ومشتقات نفطية لتلبية احتياجات المواطنين.
الباحث يونس الكريم، قال إن الحكومة السورية فتحت باب استيراد النفط أمام التجار لثلاثة أسباب، الأول للقول إن هناك انفتاحًا اقتصاديًا في سوريا، والثاني لتعزيز عملية الخصخصة، والقول إن البلاد كلها تسير إلى الخصخصة، وإن الاستثمارات متاحة أمام التجار والشركات الاستثمارية.
أما السبب الثالث، فهو للتغطية على من يقوم بالاستيراد، لأن عمليات استيراد المحروقات السابقة أو التي تتم حاليًا ليس واضحًا من يقوم بها، هل هو القطاع الخاص أو الحكومي، وبالتالي فتح باب المناقصات يحقق هذا الهدف، وفق الكريم.
معوقات لا تشجع الاستيراد
في ضوء فتح باب المناقصات، لفت الكريم إلى وجود عقبات قد لا تشجّع التجار على الاستثمار واستيراد النفط، وأبرزها أن مصفاة النفط في بانياس وحمص تحتاجان إلى ضخ أموال جديدة لإعادة ترميمهما، وتحسين قدرتهما على استيعاب كميات النفط التي يجري استيرادها.
وأضاف الكريم أن العقبة الثانية تتمثل في أن عمليات الاستيراد مع عدم وجود إنتاج محلي يستهلك المحروقات، تشكل عبئًا واستنزافًا للقطع الأجنبي، لأن العرض سيصبح أكثر من الطلب، وبالتالي تصبح عملية الاستيراد مجرد حالة إسعافية لا ربحية، ومحاولة للتلاعب بالعامل النفسي للمواطن، بأن هناك بواخر نفط تصل إلى سوريا.
العقبة الثالثة تتمثل في عدم انضباط الوضع الأمني، الذي قد يعرّض شحنات النفط التي يجري تكريرها ونقلها ضمن الأراضي السورية للخطر، ولا سيما مع استمرار فلول النظام بزعزعة الأمن والاستقرار في البلد.
إمدادات الطاقة العربية..
رهن السياسة الأمريكية
شحنات النفط التي بدأت بالوصول إلى المواني السورية كانت من روسيا، البلد الذي يحاول تكوين علاقات سياسية جديدة مع دمشق مأخوذًا بماضٍ سياسي مقلق، لكن هذه الشحنات لا تغطي احتياجات البلد بطبيعة الحال، ليبرز هنا دور عربي إقليمي في هذا الملف أيضًا، فقطر، الدولة العربية الداعمة للحكومة الجديدة، طرحت مبادرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، للمساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، وفق اتفاقية تشمل صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يشرف على التنفيذ الفني للمشروع.
ووفقًا للتصريحات الرسمية، فإن قطر ستسهم بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وسيسهم الغاز القطري في ذلك بتوليد 400 ميغاواط من الكهرباء، ما يؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى أربع ساعات يوميًا، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في سوريا.
وبحسب وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه سوريا نقصًا حادًا في إنتاج الكهرباء بسبب شح الغاز والفيول، في وقت أوضح الجانب الأردني الذي يمر عبره الغاز أن الاتفاقية قصيرة المدى.
ويؤثر نقص الكهرباء سلبًا على حياة المواطنين، ويعرقل جهود الحكومة في تحسين البنية التحتية للطاقة وخلق بيئة استثمارية مشجعة، بحسب الوزير.
وأضاف دياب، في 14 من آذار، أن المبادرة تمثل دعمًا مهمًا لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، وتعزز قدرة سوريا على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي، قال حينها، إن هذه الخطوة “محورية نحو تلبية احتياجات الشعب السوري من الكهرباء”، وتعكس التزامًا مشتركًا بين جميع الأطراف للعمل من أجل مصلحة المنطقة.
من جهته، قال وزير الكهرباء في حكومة دمشق المؤقتة، عمر شقروق، إن محطة “دير علي” هي المستقبل الأولي لخط الغاز العربي من الأردن، ولكن يمكن تشغيل باقي المحطات من خلاله، لأن شبكة الغاز مربوطة ببعضها.
وأوضح أن كمية الغاز الواردة، رغم أهميتها، تمثل “جزءًا بسيطًا” من احتياجات سوريا البالغة 6500 ميغاواط، لكنها ستسهم في زيادة التغذية اليومية بنحو ساعتين إضافيتين، مع توقعات بمزيد من التحسن مع نهاية شهر رمضان.
وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، حيث لا تتوفر الكهرباء الحكومية إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق.
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يلعب دورًا رئيسًا في المبادرة، فأكد نائبه في سوريا، محمد مضوي، أن البرنامج يعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء السورية ومركز “الطاقة المتجددة” في القاهرة لوضع خطة استراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد.
وتتمثل مساهمة الأمم المتحدة في تقديم الدعم المالي والفني لوزارة الكهرباء والشركة السورية للغاز، إضافة إلى المساعدة في صيانة الخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، إذا حدث أي طارئ يستدعي التدخل، وفق مضوي.
وإلى جانب الدعم القطري الذي لا يغطي الحاجة، جرى الحديث في الفترة التي أعقبت سقوط النظام المخلوع عن دور سعودي يحل محل الإيراني في تقديم إمدادات الطاقة، لكن هذا الحديث لم يبلغ مداه الرسمي، في ظل عقوبات تعرقل الحركة المالية والاقتصادية نحو دمشق، رغم تخفيف بعض الدول عقوباتها عن سوريا، وتحديدًا فيما يتعلق بالطاقة والتعاملات المالية، لكن العقوبات الأمريكية تبقى الفيصل في هذا الإطار.
الأردن أيضًا أعلن، في كانون الثاني الماضي، إطلاق مبادرة لتقديم 500 طن من الغاز البترولي المسال إلى سوريا يوميًا لعشرة أيام، في خطوة تأتي للإسهام في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها في ظل الظروف التي تمر بها سوريا، وذلك بعد مباحثات سورية- أردنية جرت بعد زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى عمان.
الباحث الاقتصادي أيمن الدسوقي، أوضح لعنب بلدي، أن الحكومة طرحت في وقت سابق مناقصات لم تلقَ اهتمامًا من قبل كبار تجار النفط، للتخوف من العقوبات، والأهم آلية وشروط الدفع، التي لم تكن تلبي شروط تجار النفط الكبار.
وبالنسبة لاستمرار المبادرة القطرية أو أي خطوة عربية لتزويد سوريا بالطاقة، يرى الباحث أن الأمر مرتبط بشكل أساسي بموافقة أمريكية في ظل بقاء نظام العقوبات، وهذه الموافقة تبقى رهن اشتراطات تجاه الإدارة السورية، والتي يبدو أنها تسير وفق خطوة- خطوة.
ورغم حرص سعودي معلن على دعم الاستقرار، فالرياض لا تميل حاليًا للانخراط المباشر في ظل بقاء العقوبات ووجود أولويات إقليمية وانتظار استقرار المشهد في سوريا وأخذ الإدارة الجديدة خطوات جدية في اتجاهات معينة، ما يعني أن المملكة العربية السعودية قد تكون انخرطت في جهود غير معلنة لدعم مبادرات استقرار سوريا، بما تمثله من ثقل سياسي إقليمي وما تمتلكه من علاقات مؤثرة على الصعيد الدولي، وفق الباحث.
وحتى قطر، التي أطلقت مبادرة الغاز، لا تتغاضى عن وجود عقوبات أمريكية معرقلة إلى حد بعيد، إذ أرجأت تقديم أموال لدعم زيادة رواتب القطاع العام في سوريا، وسط مخاوف من انتهاك العقوبات الأمريكية، ما يشكل انتكاسة جديدة أمام جهود إنعاش الاقتصاد السوري المتضرر من الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” في 26 من شباط الماضي.
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي الدكتور فراس شعبو أن جزءًا من المساعدات التي يمكن أن تقدمها الدول الصديقة والشقيقة الداعمة للدولة السورية الجديدة، هو إمدادات الطاقة من نفط وغاز وكهرباء، وطرق المساعدات هذه معفاة من العقوبات في حال كانت المساعدات لتحسين البنية التحتية للطاقة، لأن هذه المسألة تصب في خدمة المواطن لا الحكومة والسلطة.
ويرى المحلل الاقتصادي أن معظم الدول راغبة بدعم استقرار سوريا وهذا مرهون بالظروف، لأن بعض العقوبات مجمدة وليست ملغاة، ما يعني أن عودتها إذا حصلت ستكون مشكلة حقيقية، وعدم وضوح الرؤية الأمريكية مما يحصل في سوريا والتخوف السعودي وعدم دفع دول عربية فاعلة لرفع العقوبات كلها عوامل مؤثرة بانتظار كلمة أمريكية واضحة، ما يجعل الملف سياسيًا أكثر من كونه اقتصاديًا.
قطاع رافع للاقتصاد وتعافي البلاد..
عقبات يجب تخطيها
يتمتع قطاع النفط السوري بثروة هائلة تؤهله للعب دور حاسم في تعافي اقتصاد البلاد، ومع ذلك، لا تزال هناك أربع عقبات رئيسة، وفق تقرير للدكتور في الاقتصاد كرم شعار، وهي:
العقوبات الغربية المفروضة على القطاع تعوق الاستثمار الأجنبي الضروري، كما أدت العقوبات إلى انخفاض سعر بيع النفط الذي تُهرّبه “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى العراق.
ربما أدى القصف العنيف وتقنيات الاستخراج غير الاحترافية خلال الصراع إلى انخفاض دائم في القدرة الإنتاجية للعديد من حقول النفط بسبب التحولات الزلزالية. ويثير هذا الغموض شكوكًا حول قدرة سوريا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فصلًا عن التصدير، دون اكتشافات مستقبلية أو زيادة في الإنتاج، ولا يمكن تأكيد ذلك إلا من خلال عمليات تفتيش شاملة.
الوضع القانوني للعديد من الاستثمارات الأجنبية محل نزاع بالفعل، ومن المرجح أن يزداد هذا النزاع في المستقبل.
لا يزال مستقبل القطاع محل نزاع، حيث تشير التقارير إلى إصرار “قسد” على تخصيص 50% من النفط الذي تسيطر عليه لحكومتها المحلية في دولة موحدة مستقبلية.
وقال الدكتور كرم شعار، لعنب بلدي، إن الأهم اقتصاديًا في سوريا هو النفط، ولا يزال يتركز في مناطق سيطرة “قسد”، ويتوقع تشكيل لجنة خلال الأشهر المقبلة تبدأ العمل على الشبك بين الموارد، ومنح حكومة دمشق السيطرة على النفط شرقي سوريا، وفق الاتفاق الموقع بين عبدي والشرع.
وفق شعار، لا تزال هناك شكوك حول إتمام الاتفاق، وفي حال تدهورت العلاقات بين دمشق وواشنطن، فقد تضغط أمريكا على “قسد” مرة أخرى وتطلب عدم الالتزام بتنفيذ البنود.
تم إيقاف العمل بالعقوبات الأوروبية على قطاع النفط، وهذا يزيد من فرص عمل إصلاحات للقطاع، ولكن الشركات العالمية الكبرى ستبقى مترددة، لأن القطاع لا يزال معاقبًا من أمريكا، وبالتالي رفع العقوبات أوروبيًا عن قطاع النفط ضروري لكنه غير كافٍ، وليس له أثر إلا إذا تم ربطه برفع أمريكي للعقوبات.
ويبقى قطاع النفط والغاز أهم القطاعات الاقتصادية المرشحة لتكون أول روافع الاقتصاد السوري خلال فترة إعادة الإعمار في السنوات المقبلة، خاصة في حال نجاح الإدارة السورية الجديدة بإعادة إنتاج النفط والغاز في مستوياته الطبيعية التي كانت قبل عام 2011، أي الوصول إلى إنتاج النفط بما يحقق عائدًا ماليًا سنويًا قد يصل إلى 10 مليارات دولار، بناء على حساب 70 دولارًا لسعر البرميل الواحد، وفق تقرير لمركز “جسور للدراسات”.
الحاجة لإعادة تشغيل قطاع النفط والغاز تفرض على الإدارة الجديدة بناء الثقة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، والبحث عن فرص التعاون والاستثمار، الأمر الذي يتناسب مع توجّه الإدارة للخصخصة والشراكات على المستوى الداخلي والخارجي، وهو السبيل أمامها لتجاوز معوقات قلة التمويل وقلة الخبرات والكفاءات المحلية، بحسب التقرير.
وفق ورقة عن موارد الطاقة في سوريا، أوصت الباحثة بريندا شافر بضرورة أن تدعم الولايات المتحدة العملية التي تؤدي إلى عودة حقول النفط والغاز السورية إلى سيطرة الحكومة المركزية، وضرورة أن تعمل واشنطن مع أنقرة لدمج سوريا في تجارة الكهرباء والغاز الطبيعي الإقليمية.
وأوصت الباحثة بإطلاق تمويل البنك الدولي والبنوك العامة الإقليمية لمشاريع الوقود الأحفوري في سوريا، وإزالة العقوبات الغربية أو منح الإعفاءات للسماح بالاستثمار والتجارة مع سوريا.
عنب بلدي
———————–
===================
======================
تحديث 01 نيسان 2025
الإعلان الدستوري لسوريا 2025-مقالات وتحليلات- تحديث 01 نيسان 2025
——————————
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
———————————-
الإعلان الدستوري المؤقت وشكل النظام السياسي في سوريا/ رضوان زيادة
2025.04.01
عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، أعلنت الإدارة السورية في 29 كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث العربي الاشتراكي.
وأعلن الشرع في الثاني من آذار 2025، تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري، مكونة من 7 قانونيين، وسلمت المسودة في 12 آذار، ووقع الرئيس السوري على الإعلان الدستوري في اليوم التالي.
وأوضحت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي عُقد عقب تسليمه للرئيس الشرع، أنها استندت في إعداد الوثيقة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في شباط 2025.
لقد صيغت الوثيقة بالاعتماد على ثلاث وثائق تأسيسية رئيسية وهي دستور عام 1950 ومؤتمر خطاب النصر والبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني حيث اعتبرا وثيقتان تأسيسيتان وهو ما أشارت له ديباجة الإعلان الدستوري عندما تحدث أنه “واستنادا إلى القيم العريقة والأصيلة التي يتميز بها المجتمع السوري بتنوعه وتراثه الحضاري، وإلى المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة، وحرصا على إرساء قواعد الحكم الدستوري السليم المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة، ولا سيما دستور عام 1950 -دستور الاستقلال-، وإعمالا لما نص عليه إعلان انتصار الثورة السورية الصادر بتاريخ 29 كانون الأول 2025، الذي يُعد أساسا متينا لهذا الإعلان”.
فكيف يمكن قراءة السياقات السياسية التي رافقت هذا الإعلان في ضوء الدساتير السورية والنظام السياسي السابق الذي كان معمولا به في سورية، لقد ساد الدستور السوري لعام 1973 والدستور الأخير لعام 2012 نظام حكم هجين. فمن جهة كان نظامأ أقرب إلى النظام الرئاسي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جداً، ومن جهة أخرى يعتمد جهاز حكومي تنفيذي قوي نسبياً، ولم يكن نظاماً برلماني نصف رئاسي كما هو الحال في فرنسا لأنه لا يعتمد نتائج الانتخابات البرلمانية في تشكيل الحكومات المتعاقبة ـ بل هو بعيد فعلاً عن ذلك ـ وبالتأكيد ليس نظاماً برلمانياً صافياً يكون فيه الرئيس أو الملك منصباً فخرياً لا صلاحيات حقيقية لديه مقابل صلاحيات الحكم التي تنحصر بالفائز بالانتخابات البرلمانية كالنظام البريطاني أو الهندي، وبالمقابل إن النظام الذي احتواه دستور عام 1973 (الذي كان أساساً نظرياً للحكم منذ الانقلاب الحزبي العسكري الذي قام به حافظ الأسد والذي سمي بالحركة التصحيحية لعام 1970) كان نظاماً قائماً على التناقضات.
على الرغم من أن نظام الحكم في سوريا على الصعيد النظري كان نظاماً مختلطاً حزبياً مدنياً في آن معاً، إلا أنه أعطى لحزب البعث صلاحية ومكانة كبيرة جداً حسب دستور عام 1973 مثلاً من خلال قيادته للدولة والمجتمع حسب المادة الثامنة من الدستور ومن خلال ترشيح رئيس الجمهورية من قبل القيادة القطرية لذلك الحزب.
ساد التناقض المتعدد الأوجه نظام الحكم الفعلي المنفصل عن الدستور المعمول به في سورية خلال الفترة المنصرمة، فعلى صعيد الواقع كان النظام السائد في سوريا منذ الثامن من آذار عام 1963 نظاماً أمنياً حلت فيه الأجهزة الأمنية محل الجهاز المدني الحكومي في كثير من مفاصل الحياة السياسية والمدنية الخدمية اللصيقة بحياة المواطن.
أما المستوى الثاني لتناقض النظام مع الشكل الدستوري للحكم حتى بشكله غير المتطور في الحالة السورية، فقد تركز في حلول عائلة الرئيس ونعني بها المجموعة المقربة للرئيس محل أدوات الحكم المعروفة والمنصوص عليها في الدستور. فبالنتيجة لم يشكل الدستور أي مرتكز حقيقي للحكم في سوريا بل شكل صورة باهتة عن بعض مظاهر الحكم في سورية مثل اعتماد حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع. كما أن أهمية الدستور كانت قد اضمحلت خلال فترة حكم حافظ الأسد ومن ثم ابنه بشار، فقد شهدت الساحة السورية تجاذبات عنيفة تمحورت حول الفقرات المتعلقة بدين الدولة ودين رئيسها ومصدر التشريع فيها في الفترات التي سبقت حكم البعث إلا أن ذلك الجدل وكل ما مثله من حيوية في النظام السياسي والدستوري في سوريا كان قد اضمحل وحل محله القهر العنفي المستند إلى قوة أجهزة الأمن وقوة الولاء الحزبي في نهاية السبعينيات. وحتى الولاء والارتكاز الحزبي كان قد تلاشى مع تركز القوى الأمنية محل كل ما له علاقة بالسياسة في سوريا. وكدليل على اضمحلال دور الدستور إلى حد التلاشي في سوريا إبان حقبة حافظ الأسد يمكن تذكر دور المحكمة الدستورية العليا في سوريا التي وإن احتفظت بدور مراسمي هام في فولكلور الحكم الأسدي في البداية إلا أن ذلك لم يشفع لها في نهاية حياة الأسد الأب حيث لم يتبق لها أي وجود فعلي في نهاية التسعينيات وبقيت سنوات عدة من دون مصدر تمويل للإنفاق الشهري الأساسي.
لقد تبنى الإعلان الدستوري الصادر عام 2025 شكل النظام الرئاسي المطلق وهو ما قوبل بانتقادات كبيرة من قبل السوريين خاصة فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات، حيث لا يمكن تطبيق ذلك عمليا في المرحلة الانتقالية التي تقوم على التعيين، ففي المادة 24: “يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.” كما “يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة” وهو ما وضع تحديا في العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وبنفس الوقت لم يذكر الإعلان عدد أعضاء مجلس الشعب القادم..
أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية فقد أشارت المادة 43: بأن “السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون”. لكن الإعلان الدستوري لم يتحدث عن آلية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء فقد أشار فقط إلى أنه “يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله”. وهو ما أثار التخوفات بأن يصبح الرئيس هو رئيس مجلس القضاء الأعلى كما في دستور عام 2012 في انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.
بل إن الإعلان الدستوري تحدث أن في المادة 47: بأنه “تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة”. و “تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة”. فالرئيس هو من يشكل أيضاً المحكمة الدستورية العليا من دون أن يكون هناك دور للبرلمان ممثلا في مجلس الشعب مما أضفى صلاحيات مطلقة للرئيس على السلطة التشريعية.
يبقى من النقاط المهمة التي أشار لها الإعلان الدستوري هو تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية حيث أشار في المادة 49″تُحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء” كما جرى “تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون”. وهو ربما ما يؤثر على حرية الرأي والتعبير من جهة عدم تحديد ما يسمى برموز الأسد أو جرائمه.
أخيرا حدد الإعلان الدستوري في المادة 52: “مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري. وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقا له”. وهي مدة طويلة نسبيا مقارنة بالمراحل الانتقالية الأخرى في دول الربيع العربي، والأهم أن الإعلان الدستوري لم يذكر كلمة الديمقراطية أبدأ ولم يتضمن تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يعنيه أنه بعد الخمس سنوات لا نعرف ما هو شكل النظام السياسي الذي نسعى للوصول إليه.
فلكل نظام سياسي ديمقراطي ميزاته الخاصة التي تؤدي لنجاحه، كما أن البيئة الاجتماعية والعامل الديمغرافي يلعب دوراً بارزاً في نجاح نظام سياسي معين في دولة ما. ويبقى أبرز ثلاثة أشكال للنظام السياسي الديمقراطي هي:
1 ـ النظام الرئاسي
وهو نظام سياسي شائع، يضع السلطات التنفيذية بشكل مطلق بيد رئيس الدولة الذي ينتخب بشكل مباشر من قبل الشعب. ولعل قوة السلطة التنفيذية تمنح قدرة عالية للرئيس على اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتحقيق برنامجه الذي انتخب على أساسه. ومن أبرز ما يميز الأنظمة الرئاسية هوالفصل التام بين السلطات، إذ لا يحق للرئيس أن يحل البرلمان بقرار تنفيذي أو أن يتدخل في جلساته أو أن يشارك فيها.
كما أن الرئيس في النظام الرئاسي هو المسؤول الأول أمام الشعب، وهو المخول بتعيين وزرائه الذين تتلخص وظيفتهم بتنفيذ رؤية الرئيس وبرنامجه، في حين يغيب دور المعارضة السياسية والأقليات عن السلطة التنفيذية، مما يمنح استقراراً أكبر في تلك السلطة.
غير أن النظام الديمقراطي الرئاسي لا يمكن أن ينجح إلا في مجتمع تكون فيه الحالة الديمقراطية ناضجة ومستقرة، والوعي السياسي في المجتمع عالي، كي يتقبل قرارات الرئيس المنتخب، وغياب الاتفاق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد يعسر مهمة الرئيس ويصيب الدولة بحالة شلل، كما أن هذا النظام لا يعطي فرصة كبيرة للمساءلة السياسية، ويبقى الحل الوحيد أمام الشعب لمحاسبة الرئيس وحزبه هي الانتخابات المقبلة.
2 ـ النظام البرلماني
يتميز النظام البرلماني بتداخل كبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ إن الحكومة عادة في هذا النظام تتشكل من قبل الكتلة الحائزة على أغلبية المقاعد إذ يشترط حصول الحكومة على ثقة هذه الأغلبية لتتمكن من ممارسة عملها، ويكون كذلك الوزراء أعضاء في البرلمان مع أنه يحق للبرلمان الاستعانة بوزراء من خارج البرلمان، كما تعتبر الحكومة مساءلة من قبل البرلمان سواء الحكومة ككل ممثلة برئيسها أو الوزراء بشكل فردي. ويحق للبرلمان سحب الثقة عن الحكومة، كما يحق للحكومة أن تحل البرلمان إلا أن ذلك يعني بشكل تلقائي سقوط الحكومة.
يكون رئيس الدولة في هذا النظام ذو صلاحيات رمزية أو شرفية، وقد تحال له بعض الصلاحيات في ظروف خاصة، إلا أن الرئيس عادة في النظام البرلماني ينتخب من قبل البرلمان كي لا يحظى بتأييد شعبي كبير يعطيه شرعية شعبية تضاهي تلك التي حازها البرلمان ككل وتتعدى بكثير نسبة ما حازه أي عضو في البرلمان من أصوات.
ويمتاز هذا النظام بمنح الوزراء سلطات أعلى من النظام الرئاسي، إذ إن الوزير يدير وزارته بحرية أكبر كونه مساءل بشكل شخصي أمام البرلمان، كم أن القرارات داخل مجلس الوزراء تتم بالتوافق وليس لرئيس الوزراء أن يفرض قراراته ما لم يوافق عليها نسبة محددة من الوزراء.
وتكمن أكبر ميزات النظام البرلماني بأنه يشجع على وجود حوار ونقاش جاد بين كل القوى السياسية حول القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد، وبالتالي يرفع من المستوى السياسي في الدولة والمجتمع، ويزيد الثقة والتواصل بين القوى السياسية. كما أن هذا النظام يسمح للقوى السياسية الصغيرة والأقليات بلعب دور هام في السلطة.
في المقابل فإن غياب الفصل بين السلطات الثلات في هذا النظام والانصهار بين السلطات الثلات قد يقود إلى استغلال السلطة والاستبداد بها خصوصاً في الدول النامية والتي تفتقد لمؤسسات ديمقراطية قوية، كما أن موعد الانتخابات في هذا النظام غير ثابت ومن حق رئيس الوزراء البقاء في منصبه طالما يملك ثقة أغلبية البرلمان، وهذا يعني أن من حق رئيس الوزراء أن يدعو إلى انتخابات جديدة مبكرة متى رغب في ذلك خصوصاً عندما يشعر بأن الشعب يؤيد سياساته. ولعل من عيوب هذا النظام هو أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يتم اختيارهما من قبل الشعب وبهذا فسوف يكون من الصعب على الشعب محاسبتهما إلا من خلال ممثليه. كما أنه في كثير من الأحوال قد تلعب أحزاب صغيرة دوراً كبيراً يفوق حجمها الشعبي في تقرير كثير من الأمور الحاسمة ومنها تشكيل الحكومة واتخاذ بعض السياسات.
3 ـ النظام شبه الرئاسي أو شبه البرلماني
وهو نظام سياسي يخلط بين كلا النظامين السابقين، إذ يتشارك رئيس الوزراء الحائز على ثقة البرلمان أو المنتخب من قبله ورئيس الدولة المنتخب شعبياً في السلطة التنفيذية، وتتوزع الصلاحيات بين كلا الرئيسين، بيد أنه يحق للبرلمان مساءلة رئيس الوزراء وتغييره إن ارتأى ذلك.
ويتميز هذا النظام بأنه في حالة الانسجام بين رئيسي الدولة والحكومة، إذ تكون عملية سن القوانين واتخاذ القرارات سلسة ومرنة، ويحدث استقرار كبير في إدارة الدولة، كما يحق للرئيس في حالات معينة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
إلا أن أبرز عيوب هذا النظام تتمثل في حالة عدم التوافق والانسجام بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، مما يحدث حالة من الشلل في الدولة، خصوصاً لو انتمى رئيس الوزراء لحزب يعارض سياسات رئيس الدولة، كما قد يلجأ الرئيس في هذا النظام إلى إساءة استخدام سلطته بحل البرلمان، وقد يضطر للجوء إلى استفتاء الشعب كلما تعارضت السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من العيوب التي ترافقت مع آلية إصدار الإعلان الدستوري المؤقت هو توكيل مهمة اختيار شكل النظام السياسي للجنة غير منتخبة مؤلفة من سبعة أعضاء وبالتالي لم يتسم عمل هذه اللجنة بالشفافية وبنفس الوقت اتسم بالمهمة المستحيلة لإرضاء السوريين الخارجين من الثورة بشكل النظام السياسي الذي يرغبون.
ولذلك ذكرت أنه كان من الأفضل أن يصدر هذا الإعلان عن مجلس الشعب المعين وهذا ما سيعطيه مزيدا من الصدقية والشرعية، سيما أنه تبنى شكل النظام الرئاسي للدولة، وهو بالمناسبة أفضل لسوريا في الوقت الحالي في ظل تزايد النزعات الإقليمية وضعف المؤسسات الوطنية فتحتاج إلى تقوية الحكومة المركزية في دمشق ضمن هذه المرحلة الانتقالية، لكن بنفس الوقت كان لابد من فتح المفاوضات مع كل الأطراف السورية التي لها مصلحة في المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الأقليات الدينية والإثنية والذين يرغبون في المشاركة في الحكومات المؤقتة والدائمة، هذه المفاوضات عادة ما ترتكز على إطار عملية الانتقال ذاتها، ولكن يمكن أن تتضمن أيضاً التفاوض حول الدساتير المؤقتة والدائمة. حيث إن هذه المفاوضات يجب أن تكون شاملة في معظم الأحيان لجميع الأقليات مما يضمن نجاح المرحلة الانتقالية.
تلفزيون سوريا
———————————
===================
======================
عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 01 نيسان 2025
تحديث 01 نيسان 2025
——————————
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
——————————-
التقارب السوري التركي ومواجهة القوى المعادية للنظام السوري/ رياض معسعس
تحديث 01 نيسان 2025
يقف النظام السوري الجديد على حبل مشدود في محاولة تثبيت أركان حكمه داخليا بتحقيق الأمن، والسلم الأهلي، والعدالة بقصاص كل من تلوثت يداه بدماء السوريين، وتفعيل عجلة الاقتصاد والسعي حثيثا برفع العقوبات التي كانت مفروضة على النظام المخلوع، وإعادة البناء لكل ما دمره النظام البائد، والاستعداد لعودة حوالي 8 ملايين لاجئ من الخارج، وأربعة ملايين نازح، ورفع مستوى معيشة المواطن، وبناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة، وعلى رأسها الجيش السوري بضم كل الضباط والعناصر المنشقة عن جيش النظام المخلوع، وصياغة دستور دائم للبلاد يأخذ بعين الاعتبار كل الخصوصيات لجميع مكونات الشعب السوري، وفتح الباب أمام تشكيل الأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان حريتها في العمل، وملفات عديدة مفتوحة تجعل أي حكومة يتم تعيينها من عتاة التكنوقراط أمام صعوبات جمة يتوجب عليها التغلب عليها. لكن الأصعب من ذلك أيضا هو تحقيق سلامة الأراضي السورية وسيادتها وحمايتها من التقسيم، ومن مخططات القوى الخارجية، وخاصة المحيطة بها أو التي كان لها نفوذا فيها سابقا والتي تتربص بها شرا، وعلى رأس القائمة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهنا تكمن عقدة النجار.
التحالف مع تركيا
لا يمكن لسوريا التغاضي عن الجار التركي فعلاقتها مع هذا الجار تعود إلى عام 1516 التي دخلها بعد انتصاره على المماليك في معركة مرج دابق بقيادة السلطان سليم الأول، (والتكية التي بناها في دمشق ماثلة إلى اليوم تؤرخ لهذا الحدث،) ومكث في سوريا لغاية سقوط السلطنة بعد الحرب العالمية الأولى، وكان يعتبرها (سوريا الكبرى) درة تاج طوب قابي. ورغم الخطأ الكبير الذي ارتكبه العرب في تحالفهم مع الدول الغربية المعادية لها والذي جر عليهم ويلات وعد بلفور، وسايكس بيكو، وقرارات سان ريمو بالانتداب، بقيت تركيا الملاذ الأخير لتشتت الأنظمة السورية المتعاقبة بين تحالفات عربية، وولاءات خارجية وضعها في خضم تقلبات عنيفة، وكان النظام البائد قد جلب العداوة مع تركيا بدعمه لحزب العمال الكردستاني قبل أن يتخلى عنه في معاهدة أضنة في العام 1994. والتخلي عن المطالبة بلواء اسكندرون الذي قدمته فرنسا لتركيا كهدية لثنيها عن الدخول في الحرب العالمية الثانية كحليف للمحور الألماني الإيطالي، كما تخلى سابقا عن الجولان في حرب النكسة. مع اندلاع الثورة السورية فتحت تركيا أبوابها أمام اللاجئين السوريين (حوالي 4 ملايين سوري)، ودخلت تركيا كطرف في المعادلة السورية مع القوى المتحالفة مع النظام المخلوع أي روسيا وإيران، لكن على عكس هاتين القوتين كانت تركيا تدعم المعارضة السورية السياسية والعسكرية، وخاضت معارك معها لتحرير أكثر من مدينة من قوات سوريا الديمقراطية «الكردية» المدعومة أمريكيا. ورغم تخلي الدول العربية (ما عدا قطر) عن الشعب السوري وثورته، والتطبيع مع النظام البائد، حافظت تركيا على موقفها من المعارضة السورية، وفاجأت العالم بدعمها لها لإسقاط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. هذا الموقف وضعها في مواجهة مباشرة مع كل من روسيا، وإيران، وخاصة دولة الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تربطها مع نظام المخلوع علاقات مصالح متبادلة منذ تخلي والد المخلوع حافظ الأسد عن الجولان السوري، ولم يرق لها سقوطه بتاتا فدأبت على تنفيذ سلسلة من الاعتداءات المتكررة والتوغل في الأراضي السورية، وتحريض المكونات الدرزية والكردية ضد الإدارة الجديدة.
المواجهة مع إسرائيل
في حمأة أحداث غزة والضربة التي تلقتها دولة الاحتلال بعملية «طوفان الأقصى» والمستمرة إلى اليوم، تلقت الضربة الثانية بسقوط النظام السوري الذي كان يؤمن وجودها في الجولان المحتل بعد اتفاق فصل القوات في العام 1974 إذ منذ ذلك التاريخ لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه الأراضي المحتلة، ولا حتى محاولة واحدة لتحرير الجولان عسكريا، أو دبلوماسيا، بل على العكس كانت إسرائيل تقصف وتنتهك الأراضي السورية باستمرار بعد اندلاع الثورة السورية لتدمير منشآت حزب الله والحرس الثوري الإيراني وفصائل أخرى جلبها بشار الأسد المخلوع لحماية نظامه من السقوط، ورغم كل الانتهاكات لم يكن رد النظام سوى كلام في كلام. واليوم بعد سقوطه تستمر دولة الاحتلال بضرب مراكز الجيش السوري أيضا دون رد من الإدارة الجديدة التي لا ترغب بفتح جبهة مع العدو تؤدي إلى فوضى كبيرة في البلاد لا يحمد عقباها، بل حتى لا تمتلك الإمكانيات العسكرية والمادية لمواجهتها، وهنا سيأتي الدور التركي في تأمين الحماية بتوقيع معاهدة مع الإدارة الجديدة. ويتم الحديث عن بناء قواعد عسكرية تضم دفاعات جوية متطورة تم بحثها في زيارة الرئيس أحمد الشرع لأنقرة، وهذا التحالف بين دمشق وأنقرة يجعل هذه الأخيرة في مواجهة مباشرة مع دولة الاحتلال التي تخشى عودة بناء الجيش السوري والمطالبة بتحرير الجولان، وقال مصدر أمني إسرائيلي إن «المواجهة بين تركيا وإسرائيل في المنطقة السورية أمر لا مفر منه نتيجة محاولة أردوغان المساس بحرية العمل الإسرائيلية، وفي منتصف يناير/كانون الثاني طالب أردوغان إسرائيل إنهاء الأعمال العدائية التي تمارسها في سوريا، وإلا فإن النتائج التي ستظهر ستضر بالجميع. وهنا تكمن عقدة النجار الثانية. فتركيا العضو الثاني في حلف شمال الأطلسي تجعل إسرائيل أن تعد للعشرة قبل التحرش بها خاصة وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى حصر المواجهة مع إيران فقط، وعدم فتح جبهات أخرى، والعمل حثيثا على تحقيق عمليات تطبيع تشمل أكثر من دولة عربية وعلى رأسها العربية السعودية، وقد صرح ترامب بأن أمر سوريا قد فوضه لتركيا، وتحدث المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قائلا بأن سوريا ولبنان باتا أقرب من أي وقت مضى للتطبيع مع إسرائيل. ويبدو أن الإدارة الأمريكية التي أرسلت قائمة بالشروط التي تطالب فيها الإدارة الجديدة في سوريا تحقيقها تريد أن تربط رفع العقوبات أيضا بمسألة التطبيع، وتقول بعض المصادر الفلسطينية بأنها أيضا طلبت من دمشق أن تمنح الجنسية السورية للاجئين الفلسطينيين (حوالي 600 ألف لاجئ فلسطيني يتمتعون بكل حقوق المواطن السوري ما عدا الجنسية لحماية حق العودة، وبعملية التجنيس ستسقط عنهم بطاقة الأنروا التي تضمن لهم هذا الحق)، وهذا يضع الإدارة الجديدة أيضا أمام عقدة نجار ثالثة يصعب حلها. وهكذا يبدو المشهد بأن الوضع في سوريا يتطلب الكثير من الإدارة الجديدة الكثير من العمل، والكثير من الحذر، وأكثر من ذلك التعامل مع القوتين العظميين اللتين تحتلان أيضا مراكز في سوريا ولا ترغبان حاليا بالتخلي عنها.
كاتب سوري
القدس العربي
—————————-
هيئة البث الإسرائيلية: نلاحظ اتجاهاً مثيراً للقلق يقوده الرئيس السوري أحمد الشرع
تحديث 01 نيسان 2025
كشفت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، عن قلق في تل أبيب تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع، بزعم تشدده وعمله على تقويض أمن إسرائيل.
ونقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن تل أبيب لاحظت اتجاهاً “مثيراً للقلق” يقوده الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأضاف: “الرئيس الشرع إسلامي يرتدي ربطة عنق، وهو عدو ومتشدد وليس شريكاً بالحوار”.
وتابع: “نحن نفهم أن الجولاني (الشرع) عدو يحاول بيع صورة جديدة للغرب، بينما يعمل في الوقت نفسه على تقويض أمن إسرائيل”، على حد قوله.
وادعت الهيئة أن “الشرع أفرج عن جميع عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين اعتقلوا خلال فترة حكم بشار الأسد، ومنهم من انخرط في العمل الإرهابي ضد إسرائيل”، على حد تعبيرها.
وبسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهية 61 عاماً من نظام “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وزعمت هيئة البث أن “إيران بدأت البحث عن طريقة للبقاء في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، وتمثل أحد الحلول في دعم خلايا حماس والجهاد الإسلامي داخل سوريا”.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس علَّق على أحداث العنف التي اجتاحت الساحل السوري، الشهر الماضي، بأن “الجولاني كشف عن وجهه الحقيقي بعدما خلع القناع الذي يرتديه”.
وفي 6 مارس/ آذار المنصرم، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً إثر هجمات منسقة لفلول نظام الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أوقعت قتلى وجرحى، وإثر ذلك نفذت قوى الأمن عمليات تمشيط تخللتها اشتباكات انتهت باستعادة الأمن والاستقرار.
ولفتت إلى أن يسرائيل كاتس شدد – في أكثر من مرة – على أن إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد من سوريا.
وبوتيرة شبه يومية، تشن إسرائيل، منذ أشهر، غارات جوية على سوريا، وتوقع قتلى مدنيين، وتدمر مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، رغم أن الإدارة الجديدة لم تهدد تل أبيب بأي شكل.
ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث احتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
(الأناضول)
———————————
إسرائيل: الشرع أطلق قياديين بـ”حماس” و”الجهاد”..كانوا معتقلين لدى الأسد
الثلاثاء 2025/04/01
زعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الرئيس السوري أحمد الشرع أطلق سراح قياديين من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، كانوا معتقلين في سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
“خطر حماس”
وقال المسؤولون لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، إن القادة المفرج عنهم “هددوا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل”، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز تدابيره الأمنية في المنطقة، عبر إنشاء منطقة أمنية خاصة شرقي مرتفعات الجولان، محذرين مما ووصفوه “تصاعد خطر” حركة حماس في الخارج، لاسيما في سوريا.
وتمتد هذه المنطقة على طول 80 كيلومتراً وعرض 18 كيلومتراً، وتضم تسعة مواقع عسكرية كبيرة، من بينها موقع مركزي على قمة جبل الشيخ، بهدف فصل إسرائيل عن أي تهديدات ناشئة من سوريا، حسب زعم المسؤولين.
وذكر مسؤول أمني إسرائيلي أن جيش الاحتلال لن ينسحب من هذه المناطق في المستقبل القريب، مضيفاً أن “الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر لن يعود”.
وبداية آذار/مارس، نفى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، أبو مجاهد، الادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود قوات عسكرية لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في سوريا.
وقال أبو مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية، إن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم “لتبرير العدوان العسكري وممارسة الضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام”، مؤكداً على أن “لا وجود” لقوات تابعة لـ”حماس” أو “الجهاد الإسلامي” في سوريا، كما لفت إلى أنه حتى في ظل حكم نظام الأسد المخلوع، “كان وجودنا مدنياً، يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة”.
واحتلت إسرائيل مرتفعات جبل الشيخ السورية، ووسعت وجودها داخل المنطقة العازلة في جنوب غرب البلاد، مستغلةً الفراغ الأمني والعسكري عقب الإطاحة بنظام الأسد، وذلك بزعم استهداف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي تستخدمها “حماس” و”حزب الله”.
الوجود التركي
يأتي ذلك فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعاً قريباً لمناقشة أمنية حول الوجود التركي في سوريا، بمشاركة رؤساء المؤسسة الدفاعية، وذلك بعد اجتماع مماثل الأسبوع الماضي، ناقش “النفوذ التركي المتزايد” في سوريا.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو “يتابع بقلق التقارب بين الإدارة السورية الجديدة وتركيا”، فيما نقلت عن مصادر زعمها أن الحكومة السورية تجري محادثات متقدمة مع أنقرة لتخصيص قاعدة عسكرية في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، للجيش التركي مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية وسياسية.
وادعت المصادر أن “الوجود العسكري التركي” المحتمل شرقي حمص، من شأنه أن يثير قلق إسرائيل بشكل جدي، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.
المدن
————————
مسؤول إسرائيلي رفيع: الشرع عدونا الواضح دون شك
حذّر من أن التفاهمات المتزايدة بين سوريا وتركيا قد تُقيد حرية إسرائيل العملياتية في دمشق
تل أبيب – لندن: «الشرق الأوسط»
1 أبريل 2025 م
حذَّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى من أن التفاهمات المتزايدة بين سوريا وتركيا، قد تُقيِّد حرية إسرائيل العملياتية في سوريا. ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع بـ«إنه عدونا الواضح دون شك».
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عنه، الثلاثاء، قوله: «هذا رصيد استراتيجي يجب أن نحافظ عليه. هدف تركيا هو الحد من النشاط الإسرائيلي في سوريا. لا نرغب في المواجهة، لكننا لن نتنازل عن مواقفنا أيضاً»، مشدداً على أن «عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا، تحظى بدعم كامل من الرئيس الأميركي».
وحول إمكانية إنشاء تركيا قاعدة في سوريا، قال: «لا نعتقد أن إردوغان مَن سيوفر التمويل». وفيما يتعلق بالرئيس السوري أحمد الشرع، قال: «إنه إسلاميٌّ تقليدي، وهو عدونا الواضح دون شك. إنه يعمل على رفع العقوبات عنه وتقديم نفسه رئيساً لحكومة شرعية».
القلق الإسرائيلي ليس الأول من قبل مسؤول كبير، فقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، مؤخراً، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي في سوريا، وأنه يُحاول تصوير المواجهة مع تركيا على أنها «حتمية».
ووفقاً لموقع «والا»، لفتت المصادر إلى اتصالات سورية – تركية بشأن تسليم مناطق قرب تدمر (وسط سوريا، وتعدّ منطقةً أثريةً) للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق. وأن التحركات التركية المحتملة في تدمر، وسط سوريا، تُثير قلقاً إسرائيلياً كبيراً، لافتةً في الوقت نفسه، إلى أن النظام السوري الجديد يحاول ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب بالقرب من إسرائيل.
وكان مصدر في وزارة الدفاع التركية، قد أعلن (الخميس)، أن أنقرة تدرس إنشاء قاعدة لأغراض تدريب في سوريا، تماشياً مع مطالب الحكومة الجديدة في دمشق. وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرات الجيش السوري.
وأضاف المصدر، في رده على سؤال خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع، أن «جميع أنشطتنا في سوريا يتم تنسيقها مسبقاً مع الأطراف المعنية، وتُتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرَّح بأن «إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد من سوريا. سنظل في مناطق الأمن وفي هضبة الجولان، وسندافع عن قرى الجليل والجولان. سنحافظ على جنوب سوريا خالياً من الأسلحة والتهديدات، وسندافع عن السكان الدروز هناك، ومَن يهددهم سيواجه ردنا».
الشرق الأوسط
———————————-
عن الاشتباك الجيوسياسي التركي الإسرائيلي في سوريا/ محمود علوش
2025.04.01
منذ الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول الماضي، شنت إسرائيل ما يزيد على سبعين عملية توغل برية في جنوب غربي سوريا ونفذت عشرات الغارات الجوية على ما تبقى من أصول عسكرية للدولة السورية.
وقد قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاثة مُسوغات لإضفاء مشروعية على هذه التحركات العدوانية.
الأمن، والخوف من الخلفية الجهادية السابقة للرئيس أحمد الشرع، ومشروع الشرق الأوسط الجديد الذي وعد نتنياهو بتحقيقه بعد اندلاع حرب السابع من أكتوبر. وفي حين أن هذه المُسوغات تبدو متداخلة فيما بينها من حيث الديناميكيات المتشابهة المُحركة لها ومن حيث الأدوات التي تستخدمها إسرائيل لفرض تصوراتها لسوريا الجديدة، فإن مُحرك “الشرق الأوسط الجديد”، أضفى بُعداً جيوسياسياً خطيراً على سوريا يتمثل في تحولها إلى ساحة اشتباك جيوسياسي بين إسرائيل وتركيا. ويجلب هذا البعد مزيداً من الضغط على عملية التحول وعلى جهود الشرع للحد من ضغوط الجغرافيا السياسية الإقليمية عليها.
حقيقة أن الفراغ الذي خلفه الانكفاء الإيراني في المنطقة بعد انهيار نظام الأسد وتحوّلات حرب السابع من أكتوبر وصعود تركيا كقوة فاعلة في تشكيل الجغرافيا السياسية الإقليمية المُحيطة بها جنوباً، أوجدت مساحة قوية للاشتباك الجيوسياسي التركي الإسرائيلي. وهي تُشكل دافعاً من دوافع مُتعددة للتحركات العدوانية الإسرائيلية في سوريا بعد التحول. وتستند هذه الدوافع في الغالب إلى تصور يسعى رئيس الوزراء بنامين نتنياهو لفرضه وتدعمه في ذلك الدوائر الإسرائيلية العسكرية والاستخبارية في الداخل، ويقوم على أن الحضور التركي في سوريا الجديدة يُشكل تهديداً جيوسياسياً كبيراً لإسرائيل. وعلى الرغم من أن الافتراض، الذي يدفع نتنياهو مستشاريه لنشره على وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود مخاطر حقيقية لصدام عسكري بين إسرائيل وتركيا في سوريا، لا يبدو واقعياً، إلآّ أنه لا يُخفي حقيقة الاشتباك الجيوسياسي التركي الإسرائيلي.
وهذا الاشتباك يستمد قوته من ثلاثة مُحركات استراتيجية. الأول يتمثل بالهامش الجديد الذي أوجده التحول السوري لتركيا لتحدي مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى إسرائيل لفرضه كقوة إقليمية مُهيمنة فيه ومدعوم بدرجة رئيسية بسياسة التوسع الإقليمي التي تنتهجها بعد حرب السابع من أكتوبر. ويتمثل الثاني بالبُعد السني في العلاقة الجديدة بين تركيا وسوريا بعد التحول. أما الشكل الثالث فيتمثل في أن الشراكة الاستراتيجية الناشئة بين أنقرة ودمشق تُشكل عقبة رئيسية أمام إسرائيل لفرض تصورها لسوريا الجديدة كدولة غير قادرة على الاستقرار وامتلاك أدوات القوة. إن هذه الأشكال الثلاثة تُضفي في الواقع بعداً إقليمياً مُهيمناً على التحركات الإسرائيلية في سوريا. ولا أعني بهذا البعد إضفاء صفة الواقعية على هذه التحركات بقدر ما يُفسر الدوافع العميقة لها من منظور الأمن القومي الإسرائيلي أولاً، ومن منظور مقاربة إسرائيل لتأثير تركيا على المنافسة الجيوسياسية الإقليمية ثانياً، وكذلك من منظور واقعية الهاجس الإسرائيلي من “البُعد السني” في علاقة تركيا بسوريا الجديدة.
مع ذلك، تبرز بعض المتناقضات في المقاربة الاستراتيجية الإسرائيلية لتركيا ودورها في سوريا. فمن جانب، إذا كانت لدى إسرائيل هواجس من “تطرف” القادة الإسلاميين الجدد في دمشق، فإن الاحتضان التركي لهم يعمل كمُحفز قوي لتعزيز اعتدالهم. ويبدو أن معظم القوى الإقليمية والدولية المتوجسة من الخلفية الجهادية السابقة للشرع بمن فيهم الولايات المتحدة تُراهن على أهمية الدور الذي تقوم به تركيا لتوجيه عملية التحول ولصقل الشخصية الاعتدالية للشرع. ومن جانب آخر، تعمل الغطرسة التي تُمارسها إسرائيل في المنطقة منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر على التقليل من أهمية المخاطر التي تجلبها السياسة الإسرائيلية في سوريا على إسرائيل نفسها خصوصاً لجهة أنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى مفاقمة التهديد الذي تُشكله سوريا الجديدة لإسرائيل بدلاً من تقليله، وكذلك لجهة أنها قد تجعل الرئيس الشرع أقل حذراً في المضي قدماً في تعميق الشراكة الجديدة مع تركيا خصوصاً في المجالات العسكرية.
إن نظرة تركيا وإسرائيل لبعضهما البعض كتهديد استراتيجي تتجسد بشكل متزايد في هذا الاشتباك الجيوسياسي في سوريا. وما يُضاعف من هذه النظرة النهج الإقليمي التوسعي الذي يُهيمن على السياسة الإسرائيلية في المنطقة كنتيجة لحرب السابع من أكتوبر وفي ظل قيادتها من قبل تيار يميني متطرف يعتقد أن إسرائيل أمام لحظة تاريخية لن تتكرر لتغيير الشرق الأوسط. مع ذلك، فإن الواقعية ما تزال تعمل كمؤثر قوي في تشكيل سياسات تركيا وإسرائيل إزاء بعضهما البعض. علاوة على ذلك، يُوجد الاشتباك الجيوسياسي بين البلدين تحدياً كبيراً أمام جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانسحاب من سوريا ولدفع حلفائه في المنطقة إلى التعاون فيما بينهم لإدارة الشرق الأوسط بانخراط أميركي أقل. ومن المرجح أن تعمل النظرة الجيدة التي يتبناها ترمب إزاء تركيا ودورها في سوريا كضمان لإدارة هذا الاشتباك ومنع خروجه عن السيطرة. مع ذلك، يبدو نجاح سوريا الجديدة مسألة أمن قومي لتركيا بقدر ما يبدو تهديداً جيوسياسياً لإسرائيل.
تلفزيون سوريا
——————————-
سورية الجديدة والامتحان الإسرائيلي: من التجاهل إلى دبلوماسية التناظر الإقليمي/ محمد السكري
31 آذار/مارس ,2025
يمرّ الصراع السوري الإسرائيلي عقب سقوط نظام الأسد بمنعطف مهمّ، حيث عاصر نظام الأسد ثلثي عمر دولة الاحتلال، وتغيّر شكل السلطة في دمشق، وتبدّلت تحالفاتها السياسية في الإقليم، وظهرت فواعل جديدة في المنطقة جعلت إسرائيل في موقفٍ يميل تجاه التصعيد العسكري على سورية، حيث شنّت مئات الغارات الجويّة والضربات الصاروخية، وأقدمت على احتلال مناطق جديدة في سورية جنوب البلاد، عقب انسحاب قوات الفصل الدولية.
تهدف هذه الورقة إلى البحث عن الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى توسيع احتلالها الأراضي السورية، وتجاوز الاتفاقات الدولية، وتحاول فهم السياسات الإسرائيلية الجديدة تجاه سورية، وتعمل على قراءة خيارات الحكومة السورية الجديدة في التعامل مع التصعيد الإسرائيلي.
أولًا. سياقات الصراع السوري الإسرائيلي:
الموقف السوري من إسرائيل قديم، حتى إنه سبق إعلان قيامها، فقد رفضت المملكة السورية عام 1920 مشروع ما يسمّى “الهجرة الصهيونية”، ومن ثمّ دعمت الحركة الوطنية السورية قضيةَ فلسطين، وشاركت سورية في حرب 1948، واستطاع الجيش السوري حينها السيطرة على شمال فلسطين، قبل حدوث النكبة وانهزام الجيوش العربية. ومنذ ذلك الحين، حافظت سورية على الموقف المعادي والرافض لقيام “دولة إسرائيل”، وأصبحت فلسطين جزءًا من الأمن القومي السوري.
ثم جاءت حرب 1967، وكان من نتائجها خسارة سورية هضبة الجولان، مع ذلك، يشكّك السوريون برواية الحرب، لا سيما مع وجود شهادات عديدة تُفيد بانسحاب الجيش السوري من القنيطرة، بأوامر من قيادة دمشق[1].
حاول نظام الأسد الأب استعادة المناطق السوريّة التي احتلتها إسرائيل، خلال ما يسمّى “حرب أكتوبر” عام 1973، ووقّعت سورية بعد عام اتفاقية فضّ الاشتباك برعاية الأمم المتحدة، وهي التي أسّست لمنطقة منزوعة السلاح بين الطرفين، عام 1974، ولم تكن هذه اتفاقية “سلام”، وإنما كانت اتفاقًا لـ “وقف إطلاق النار”.
وبدأت مفاوضات ضمن مسار السلام المتعثر، بين الطرفين، عام 1991، في العاصمة الإسبانية مدريد، لكنها لم تفض إلى أي اتفاق، وفي عام 2008، سعت تركيا للتوسط من أجل إعادة إحياء مسار التفاوض عبر وساطة غير مباشرة بين سورية وإسرائيل، لكن الاتفاق لم يتحقق لأسباب عديدة، منها رفض إسرائيل الانسحاب من الجولان، وحرب غزة، وعدم وجود ضمانات واضحة ضمن مسار بناء الثقة، وتزايد انخراط نظام الأسد ضمن معسكر إيران.
وبعد اندلاع الثورة السورية، عزّز التحكّم الإيراني الكبير في بنية نظام الأسد الابن اتخاذ إسرائيل موقفًا رماديًا تجاه الأسد؛ لكنه غير داعم للثورة السورية، وأخذ هذا الموقف يتطور حتى وصل إلى تنفيذ طلعات جوية وعمليات قصف داخل الأراضي السورية، بسبب تزايد الهيمنة الإيرانية، مع التنسيق المباشر مع الجانب الروسي عبر تدخل موسكو عام 2015 لدعم نظام الأسد، ولضبط الإيقاع الإقليمي.
أدّت عملية طوفان الأقصى، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى تغير قواعد الإقليم بشكل كامل، حيث قامت إسرائيل باستهداف كبير ضدّ القوى الداعمة لمحور إيران؛ الحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان وسورية، وأخيرًا داخل الأراضي السورية ضدّ إيران وترسانة جيش النظام السابق، مما جعل إسرائيل القوة الأكبر في المنطقة، بعدما استطاعت استئصال خصومها وإضعافهم. لكن سقوط الأسد كان التغيير الأكبر الذي مهّد لطرح سؤال جيوأمني وجيواستراتجي.
ثانيًا. سورية الجديدة وإسرائيل: التأرجح بين الدبلوماسية والتصعيد
عمدت إسرائيل، خلال توجّه الإنظار الدولية والإقليمية في لحظة مهمة، إلى تجاوز خطوط التماس والاشتباك العسكري، وتوغلت جنوب البلاد لتوسيع مساحة الأراضي التي تحتلها في سورية، في حين كانت الأنظار متوجهة نحو حدث سيطرة قوات إدارة العمليات العسكرية على دمشق وإسقاط نظام الأسد، وكان التحرّك الإسرائيلي بمنزلة خطوة استباقية تشير إلى سياسات إسرائيل الجديدة تجاه سورية، مما يشي بتعامل مختلف تمامًا عمّا ساد خلال الحقبة الأسدية في سورية، ولم يقتصر التحرك الأولي على الجانب السياسي، من خلال التصعيد في الخطاب والتصريحات السياسية فحسب، بل توغلت إسرائيل داخل الأراضي السورية، منذ عام 1974، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانهيار الكامل للتوافقات السورية-الإسرائيلية، ضمن اتفاقية فض الاشتباك “”Syrian-Israeli Disengagement Agreement، كونها لم تعد مفيدة للسياق السوري الجديد، وفق المصالح الجيوأمنية لإسرائيل[2].
وفي لحظة الفوضى الأمنية، سعى الرئيس أحمد الشرع وفريقه إلى إدارة الخلافات مع إسرائيل، من خلال توجيه تصريحات ترنو نحو التهدئة أكثر من الحرب، مع محاولة الموازنة بين إدانة التوغل داخل الأراضي السورية، وبين مستقبل العلاقة، ولا سيما ضمن التوجه السوري الجديد الذي ينطلق من سياسة “اللاحرب والبناء”، وقد كانت تصريحات الرئيس السوري، بخصوص عدم رغبة سورية في الانخراط بأي حرب جديدة والتركيز على البناء الداخلي فقط، من أبرز الإشارات لدول المنطقة، وعلى رأسها إسرائيل، بأن سورية لن تكون مصدر تهديد لأحد أو قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى انسحاب إسرائيل من المنقطة العازلة التي استولت عليها، وتبلغ مساحتها نحو 450 كيلومترًا مربعًا[3].
مع ذلك، لم تكن هذه التصريحات كافية لدولة الاحتلال، من أجل إعادة النظر بالسياسات التي اتبعتها عقب سقوط الأسد، بل على العكس ارتفعت موجة الانخراط والتهديد العسكري للأراضي السورية، من خلال استمرار سياسة استهداف المواقع الاستراتيجية للجيش السوري، من أجل تفكيك ما تبقى من الترسانة العسكرية، بجانب التوغل العسكري الذي وصل إلى درجة الحدود الإدارية لمحافظة درعا، ونجم عن هذا التوغل استحداث مواقع عسكرية تزيد على 8، ما عدا القدرة على المراقبة النارية التي باتت على بعد 23 كيلومترًا من العاصمة السورية دمشق. وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية عدم السماح لقوات الحكومة السورية بالانتشار جنوب سورية، مع المطالبة بأن تكون المنطقة الجنوبية منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل[4].
وفي ظلّ ارتفاع مؤشرات تحوّل الفعل الإسرائيلي من تهديدات وتوغل مؤقت، إلى احتلال عسكري يغيّر خارطة التموضع داخل سورية، توجّهت الإدارة السورية لإعادة النظر بالفعل السياسي، ومن ضمن ذلك الخطاب العام، وقد جاء في البيان النهائي للمؤتمر الوطني في دمشق، ضمن البند الثاني، إدانة صريحة للاحتلال، ورفض للتنازل عن أي شبر من الأراضي السورية، بعدما توضح أن المطامع الإسرائيلية تتجاوز التعامل مع حالة الفراغ، وتصل إلى الاستثمار بفرصة سقوط الأسد، من أجل زيادة الأراضي التي تسيطر عليها، ليكون العامل الأمني مسوغًا واقعيًا لتجاوز التوافقات الدولية والأممية.
شكّلت ردات الفعل والمواقف الدولية والإقليمية حافزًا إضافيًا للحكومة السورية الجديدة، من أجل زيادة مستوى فعالية الخطاب والتدرج من الدبلوماسية المرنة نحو “الدبلوماسية القسرية”، وكانت نقطة التحوّل زيارة الرئيس الشرع لتركيا ولقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مع ازياد تخوّف إسرائيل من بدء مسار تنسيق من أجل توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين[5].
في السياق ذاته، وجدت الحكومة السورية في التفاعل الإقليمي والدولي، وفي تفعيل القنوات الدبلوماسية في العلاقات الدولية، فرصة مهمة من أجل ردع العدوان الإسرائيلي على سورية. وتستغل إسرائيل تلك التناقضات ضمن المجتمع الدولي تجاه دمشق، من أجل زيادة حجم نفوذها داخل سورية.
مع ذلك، ساعد الوضع الإقليمي والدولي الحكومة السورية في تدعيم موقفها، وذلك في أثناء تمييز الدول بين الموقف من الحكومة السورية الجديدة، والموقف من القصف الإسرائيلي وانتهاك السيادة السورية، حيث اتسم التفاعل الدولي والإقليمي بالفعالية، وتشكل نوع من الموقف الدولي الرافض، حيث تنقسم المواقف بين الإدانة الصريحة لإسرائيل، وإدانة الفعل من دون تحديد المسؤول، كما جاء في التصريحات الأميركية والألمانية والأوروبية. ومن الملاحظ أنه لا يوجد تغيير في المواقف التقليدية من سورية، من قبل بعض الدول التي ما زال موقفها مترددًا أو رافضًا للحكومة السورية الجديدة وكانت على وفاق مع نظام الأسد سابقًا، كالعراق وإيران وروسيا الذين أدانوا الاستهداف الإسرائيلي لسورية.
تؤدي الاعتراضات المستمرّة ضد حكومة نتنياهو داخل إسرائيل إلى الحد من قدرتها على استمرار سياسة التصعيد، كخيار مستمر، مما يؤدي إلى اقتصارها على سياق زمني ومرحلي محدد، في ظل عودة الاحتجاجات داخل إسرائيل، بسبب سياسات نتنياهو الداخلية التي تزيد من استياء المعارضة[6]، لا سيما في ظل التخوف من أن تؤثر تلك السياسات في تعريض ما يسمّى “مسار السلام الإبراهيمي” للخطر، بسبب السياسات القائمة على الحرب بدلًا من السلام، أو فقدان فرصة التهدئة في المنطقة عقب إضعاف إيران، ولا سيما في ظل تزايد الحديث الأميركي عن وجود فرصة لسلام مع سورية ولبنان، كما جاء على لسان المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف[7].
ثالثًا. المطامع والتخوفات الإسرائيلية والسياسيات المتبعة:
ترتّب على إسقاط الشعب السوري لنظام الأسد تغيّر كبير في قواعد الاشتباك الإقليمية، ولطالما اتسم الملف السوري ببعده الدولي فضلًا عن البعد الإقليمي، ولعلّ تعقّد الملفّ السوري جعله من أولويات الدول الفاعلة به، وجعله يحوز اهتمامًا يصل إلى الصراع على المكتسبات[8]. ويشير الواقع الجديد، من حيث التوازن وتموضع القوى، إلى أنّ الملف السوري سيكون ملفًا استقطابيًا لكل من إسرائيل وتركيا، عوضًا عن روسيا وإيران وتركيا، حيث وضع الواقع السوري الجديد إسرائيل وتركيا في خط التقاء بريّ، لأول مرّة منذ الحرب العالمية الأولى.
ساعد تشكّل السلطة السورية الجديدة في إعادة بناء منظومة التحالفات غير التقليدية التي اعتادتها إسرائيل، مما يشكل حالة قلق وتهديد غير عادي بالنسبة لإسرائيل ومصالحها في سورية، لا سيما في ظل نمو الدور التركي واتساعه وتطوره من مجرد فاعل في شمال سورية إلى حليف استراتيجي للحكومة السوريّة. وقد شكل هذا الأمر الدافعَ الأساسي لإسرائيل، من أجل التقدّم جنوب البلاد على حساب القوات التركية شمال سورية، فمجرد نمو الدور التركي يجعل إسرائيل في حالة من التوجس، أي أن تكون سورية مدعومة من دولة حليفة وعضو في الناتو. وعلى الرغم من وجود مؤشرات أمنية وسياسية عديدة يمكن أن تشكّل تهديدًا على إسرائيل، يبقى الخوف هو الدافع الأول للارتباك[9].
عززت توجهات الحكومة السورية الجديدة، من حيث عزمها توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع أنقرة، من القلق الإسرائيلي، وهذا يعني أن هناك حالة يقين لدى تل أبيب بوجود علاقة خاصة غير معتادة بين دمشق وأنقرة، ومما يُغذي التخوفات الإسرائيلية، التوجهاتُ التركية الأخيرة، عقب حرب أكتوبر، تجاه المنطقة وتوتر العلاقات بين الجانبين. أمّا التخوف الأبرز فيدور في فلك تشكيل سورية الجديدة، بما يتناسب مع المصالح السورية مع تقاطعها مع المصالح التركية، وليس وفق مصالح الإقليم أو الرؤية الإسرائيلية تجاه المنطقة[10].
هذا التغير في تحالفات دمشق دفع إسرائيل إلى استخدام كل الأوراق المتاحة، بهدف ضبط الإيقاع واستعادة زمام المبادرة بما يحقق المصلحة الإسرائيلية، وينطلق هذا التغير من تعزيز الفوضى وعدم الاستقرار أو “الفوضى المدروسة“، من خلال خلق تحديات أمنية جنوب البلاد، ومنع عودة الجيش السوري الجديد للسيطرة على الجنوب، ضمن مساعيه لتكون منطقة “خالية السلاح”. وزادت تل أبيب من أدواتها عبر استخدام الكرت الطائفي، في ملفي مدينة جرمانا ومحافظة السويداء، عبر تأليب الرأي العام على دمشق، حيث كان هذا النوع من التدخل على مستوى الخطاب الإسرائيلي غائبًا، خلال فترة حكم نظام الأسد، وقد عبّر نتنياهو عن استعداد إسرائيل للتدخل في حال المساس بالمكون الدرزي في سورية، معولًا على الخلافات البينية داخل الطائفة الدرزية حول طبيعة العلاقة مع دمشق، وقد وصلت التطورات إلى زيارة وفد من دروز سورية للجولان لأول مرة منذ عقود، وهي مؤشرات تعكس حجم الاستقطاب والاستمالة[11].
وهذا يعني أنّ إسرائيل تحاول تفكيك المكونات السورية “الأقليات” واستغلالها، باستخدام سياسة استمالة الطوائف كأداة لتبرير النفوذ، ولعلّ ظهور تيارات وطنية داعمة للتوافق مع الحكومة السورية في السويداء قد عرقل المطامع الإسرائيلية، إذ إن ذلك يعرقل استخدام كرت الأقليات من حيث النجاعة، لكنّه يفتح المجال لاستخدام كرت الأقليات داخل الأقليات السورية، في ظل وجود أطراف عديدة، وعدم وجود تعاقد اجتماعي سوري-سوري، حتى الآن.
ولعلّ ما هو أكثر خطورةً في هذا الجانب شعور المكونات السورية بأنّها بموضع تبرير دائم، بسبب الإحراج الإسرائيلي المستمر. وقد وظّفت إسرائيل كرت الأقليات من أجل تنفيذ عملية عسكرية تحت غطاء “حماية الأقليات السورية”، كسبب وتبرير يضاف إلى العامل الأمني، مما يجعل سورية مفتتة وضعيفة وغير موحدة، ما دامت تحالفات الحكومة السورية لا تصبّ في مصلحة الرؤية الإسرائيلية في المنطقة.
فمن الخيارات التي تحاول إسرائيل اللجوء إليها، عودة الدور الروسي في سورية، كضامن يحقق التوازن داخل الملف السوري، مما لا يصنع تهديدًا على حكومة تل أبيب، وبالتالي، تقل احتمالية وقوع مواجهة مع الجانب التركي والحكومة السورية. وترى إسرائيل أن عودة الانخراط الروسي تقلّص من الدور التركي في سورية، إلا أنّ الاشتباك التركي- الإسرائيلي سيكون تطورًا خطيرًا، يخشاه الجانبان ويحاولان تجنبه، في ظل المحاولات الإسرائيلية المستمرة خلال السنوات الماضية تجنب خصومة أنقرة.
تتركّز الأهداف الإسرائيلية على الآتي:
– جعل الدولة السورية ضعيفة وهشة، وتدمير ما تبقّى من ترسانة الجيش السوري بشكل كامل، وعدم السماح لتحقيق الاستقرار منعًا لتشكيل دولة سورية قوية.
– فرض طوق أمني جنوب البلاد، وإبعاد الجيش السوري عن الحدود قدر الإمكان، الجيش الذي يتمثل بالجماعات التي تدين بالعقيدة الوطنية لسورية، وليس كما كان سابقًا تابعًا لإيران أو روسيا.
– تقديم إسرائيل نفسها على أنّها حامية للأقليات السورية، وذلك عوضًا عن نظام الأسد، وعبر الاستثمار بمحافظة السويداء والخلافات مع الحكومة السورية، وتجزئة البلاد وتقسيمها إلى دوليات عرقية وطائفية، أو فرزها لمجموعات تدين بالولاء للهويات الفرعية بدلًا من الوطنية.
– الحفاظ على مركزية الإقليم، بوصفها القوة الإقليمية الوحيدة التي تستطيع فرض هيمنتها على الإقليم ككل، مما يقلل من فرص تركيا أو السعودية، ويزيد من حصار الدول العربية، ولا سيما الأردن والعراق ولبنان.
– دعم رؤيتها الاستراتيجية بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي العربية، في سورية خاصة، حيث تمثل لحظة الفراغ الأمني فرصةً مهمة لها تتقاطع مع أهدافها.
تسهم إسرائيل في دور المخرّب في سورية، ولا تستهدف دمشق فقط، وإنما يأتي ذلك في سياق استمرار الهيمنة على دول المنطقة، ضمن القواعد المرسومة والتوافقات التي تحقق المصالح الإسرائيلية فحسب، ولعلّ زيادة هذا التوجه لا تضر سورية فقط أو تؤثر في تركيا وحدها، وإنما تجعل لبنان والأردن أيضًا في موقف محرج، فسيناريو سيطرة إسرائيل على جنوب سورية يعني تطويق عمّان جيوسياسيًا، وممارسة مزيد من الضغوط على الإقليم، مما يؤدي إلى زيادة التصعيد وارتفاع فرص الاشتباك السياسي والأمني[12].
رابعًا. الخيارات السورية في المواجهة والضبط:
تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات أمنية عديدة، على مستوى استعادة سيادة سورية، والتعامل مع المخاطر الإقليمية، على رأسها الإسرائيلية التي لطالما فضلت الاستبداد والسلطة المركزية الضعيفة المنصاعة، على وجود دولة سورية مستقرة تمثل إرادة الشعب السوري، وتخشى إسرائيل من أيّ عودة لثنائية الحرية-الأمن، ضمن حدود الدولة السورية الجديدة، لما تشكله من خطر سوري استراتيجي على المدى الطويل، مع ذلك لدى الحكومة السورية خيارات عديدة للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية:
– تفعيل القدرة الدبلوماسية لاستخدام مبدأ الوساطة الدولية:
من المهمّ أن تستعيد الحكومة السورية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، من خلال إجراء تقدّم في الملفات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، والتدرّج نحو الانتقال إلى حالة محلية وطنية سورية، ونزع تصورات التهديد (Threat Perception) وبعث الاطمئنان بأن سورية لن تكون مصدرًا للتهديد، ونزع ذرائع عدم الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، حيث تترقب الولايات المتحدة السلوكَ السوري، وقد عبّرت الخارجية الأميركية عن ذلك بالقول إنّها تقوم بالنظر بموقفها الأولي من دمشق. وستساعد القدرة على استعادة الثقة مع واشنطن في استخدام مبدأ “الوساطة”، لكبح إسرائيل عن أي استهداف للأراضي والسيادة السورية، مما يمهّد للاستقرار، ولا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث عن إيقاف الحروب في الشرق الأوسط، وعن التركيز على الاستقرار الإقليمي، حيث إن التصعيد الإسرائيلي على سورية لا يخدم مقاربة ترامب الجديدة تجاه الشرق الأوسط، بل يجعله أكثر فوضى[13].
– توقيع اتفاقيات دفاع مشترك مع أنقرة كخيار للدبلوماسية القسرية:
يزيد التعاون والدعم التركي للحكومة السورية من فرصها في تحقيق التوازن الإقليمي داخل الملف السوري، ولا سيما أن تركيا تعدّ دولةً ذات مركزية إقليمية، ولها حضور أمني مهم في العراق وسورية وقره باغ. بالتالي، يعزز تموضع تركيا في الإقليم، وثقلها على المستوى الدولي من حيث إنها فاعل أساسي في حلف شمال الأطلسي، من قدرة الحكومة السورية على ردع المخاطر الإسرائيلية، ولا سيما في حال توقيع الجانبين السوري والتركي اتفاقية دفاع مشترك، لكن شريطة أن تكون ضمن مساحات عدم الاستفزاز، إلّا في حال بلوغ التهديد الإسرائيلي مستوى الاجتياح. ويساعد الدور التركي في ممارسة تركيا دور الوساطة والتنسيق أو الضغط على تل أبيب، مستفيدةً من حضورها وقنواتها الإقليمية والدولية، ولا يقتصر ذلك على الدعم السياسي، وإنما يمكن أن يمتد عسكريًا لدعم الجيش السوري، وتوسيع قدراته العسكرية، وإعادة بناء الجيش ليكون قوة ردع حقيقية، ويزيد فرص نجاح التحالف السوري-التركي وجودُ خطوط إمداد بريّة على الحدود السورية التركية، مما يجعل تكرار سيناريو غزة في جنوب سورية ضعيفًا ومحفوفًا بالمخاطر؛ ما قد يؤدي إلى تراجع الحماسة الإسرائيلية. وتعتمد العلاقات السورية التركية على نظرية “Win-Win” في العلاقات الدولية التي تحقق الفائدة والمصلحة و “الربح” لكلا الطرفين، ولا يقتصر هذا التعاون على بعده التكتيكي فحسب، وإنما يمتد ليكون استراتيجيًا، إذ يمنح سورية مظلة للحماية الإقليمية في مرحلة استعادة عافيتها، مما يصنع لها مع الوقت خيارات عديدة ضمن سياسة “الصبر الاستراتيجي“.
– بناء مسار إقليمي مشترك وإدارة المتناقضات:
تستطيع سورية تحويل التهديد الإسرائيلي على سيادتها لفرصة، من خلال توضيح خطورته على الإقليم ككل، مع توفير علاقات ثنائية وإقليمية مع المملكة العربية السعودية تتسم بالبعد الاستراتيجي ويعيد الثقة بين البلدين انطلاقًا من العداء المشترك لإيران ورغبة سورية في استعادة العلاقات مع واشنطن والانخراط في المعادلة الإقليمية الجديدة، حيث تعتبر الرياض من أهم الدول العربية من حيث الثقل الإقليمي على المستوى العربي إذ يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في حال تدخل الرياض كوسيط بما تمتلكه من ثقل لإيقاف انتهاك السيادة السورية، وذلك بالاستفادة من تطوير مبدأ الوساطة الإقليمية كما حصل بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود السورية-اللبنانية بعد توترات أمنية.
كما أنّ بناء سورية، أدوات ثقة مع الجانب المصري وتذليل عقبات العلاقات الثنائية يعزز من القدرة السورية في مواجهة المخاطر الإسرائيلية، وذلك عبر إعادة ربط التهديدات الإسرائيلية على سورية بالإقليم ككل بعدما سعت إسرائيل لتجزئة المخاطر مستخدمة ذرائع ثنائية المحاور والتحالفات بين إيران-إسرائيل، بما في ذلك تجاه الدول الحدودية لسورية على رأسها الأردن، التي ستكون أبرز المتأثرين من التوغل الإسرائيلي داخل الحدود السورية ، كما أنّ تراجع إسرائيل عن اتفاقية فض الاشتباك يهدد بانهيار الإطار القانوني الذي كان يضبط الحدود السورية لعقود طويلة، هذا الانسحاب من الالتزامات الدولية يهدد بانزلاق الإقليم في مجمله نحو تصعيد كبير يخلق الفوضى وعدم الاستقرار، السياق الذي لا تؤيده الإدارة الأمريكية الجديدة أو المملكة العربية السعودية وقطر. ويكمن خطورة التوغل الإسرائيلي في سورية بزيادة تطويق الأردن وتراجع أي فرص لعودة الحياة التجارية بين البلدين لطبيعتها مما يهدد الأمن القومي الأردني. يجعل ذلك، خيار الاستقرار مرتبط بمصالح جيران سورية ولا يقتصر على مصلحة دمشق وحدها. يتيح ذلك الفرصة لسورية أن تطرح مسألة الاستقرار والعودة لاتفاقية “فض الاشتباك” كملف إقليمي وليس سيادي سوري فحسب أي أنّها تمتد لأمن الدول المجاورة، مما يساعد على التعاون الإقليمي لمواجهة الخطر الإسرائيلي ويشكل ضغطاً على تل أبيب، كما أنّ توظيف هذه الورقة يساعد على تشكيل جبهة إقليمية داعمة لسورية.
– استغلال مبدأ السيادة والهيمنة في المؤسسات الدولية:
إنّ استعادة سورية لسيادتها وشرعيتها، وعودة انخراطها وتفاعلها ضمن المنظومة الدولية، يعني عودة مكانتها السياسية كدولة ذات سيادة كاملة على أراضيها، وتفعيل أدواتها الدبلوماسية التي تمكنها من تشكيل رأي عام دولي مضاد لانتهاك إسرائيل للسيادة السورية. فعودة الانخراط السوري في المنظومة الدولية يخلق فرصة للحكومة السورية للاعتماد على المؤسسات الدولية والأممية، كالجمعية العمومية ومجلس الأمن، لطرح الاعتداءات على السيادة وتدويل الملف. وكلما استطاعت دمشق تحقيق التوازن في علاقاتها مع القوى المناوئة للغرب أو الداعمة له، ارتفعت فرص تطبيق سياسة الحياد الإيجابي واستمالة المواقف الدولية، والالتفاف حول الموقف السوري من الانتهاكات، ولا سيما في حال استعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا والصين، لكن مع الحذر ألّا تصل إلى مستوى الانزلاق نحو التدخل في الشؤون الداخلية، وتمنح هذه السياسة مظلة دولية أوسع لسورية، ومساحات أوسع لمواجهة تلك المخاطر والحد منها أو الوصول إلى تسويات بتشكيل مسارات إقليمية مبنية على التفاهمات، بحضور القوى الأساسية، كسورية وتركيا والأردن وروسيا وإسرائيل. (فلوريش).
– توظيف التكنولوجيا في حماية الأمن القومي:
يأتي توظيف التكنولوجيا كعامل ردعي، حيث استطاعت المعارضة السورية خلال فترة الثورة توظيف التكنولوجيا فيما يخدم عملياتها الأمنية والعسكرية مما جعلها متفوقة في التكنولوجيا العسكرية على نظام الأسد، وقد برزت طائرات “الشاهين” خلال تشكيل غرفة العمليات العسكرية 2024، رغم الظروف الصعبة التي كانت تُحيط بالمعارضة حيث استطاعت القوى الثورية الحصول على معلومات حيوية عن تحركات الجيش النظامي، ومع تحوّل تلك القوى لحالة الدولة تزداد فرص القدرة على تطوير أنظمة أمنية وعسكرية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو الطائرات المسيرة مما يعزز القدرة على السيطرة على الحدود وأنظمة دفاع فعّالة، وإنشاء منظومة مراقبة وتطوير تقنيات إنذار مبكّر.
– نزع الاستثمار بالهويات الفرعية والكرت الطائفي والتعامل مع التحديات الداخلية:
تعوّل إسرائيل على الاستثمار في تفكك النسيج الاجتماعي السوري، وسط احتياج الحكومة السورية إلى الوقت والدعم من أجل التعامل مع تركة نظام الأسد الثقافية والاجتماعية. وإنّ قدرة الحكومة السورية على تجاوز التحديات الفصائلية مرتبطة بالقدرة على “صهر” قوات أحمد العودة والفصائل المنتشرة في درعا ضمن ترتيبات الجيش السوري، وعدم الاكتفاء بالدمج، وتجاوز تحدي عدم وجود جسر عسكري بين دمشق والجنوب، ولعل الإسراع في هذا الانتقال يقلل من مستوى التحديات الأمنية، ويسهم في الوصول إلى تسوية مع مشايخ العقل في السويداء بخصوص المحافظة، وإن زيادة مستوى التنسيق والحوار والدبلوماسية الوطنية، بالتعاون مع القوى الداعمة للحكومة، تقلل من إمكانية استثمار الكرت الطائفي، وتقلل التدرج نحو تطبيق خارطة طريق إعادة الإعمار المجتمعي عبر ملفات العدالة الانتقالية، والتعاقد الوطني، وتقلل قدرة إسرائيل على توظيف العوامل الاجتماعية السورية لخدمة أجندتها الذاتية.
– إدارة النهج والخطاب الوطني السوري:
تسعى إسرائيل لاستخدام ملفات عديدة في إطار الخطاب والنهج السوري، حيث تعاني المنطقة الجنوبية ضعفًا كبيرًا في الخدمات العامة والاقتصادية، كحال معظم المحافظات السورية، مما يسهّل على إسرائيل القدرة على استغلال هذه الثغرة، عبر تقديم وعود اقتصادية وخدمية لسكان المناطق التي تحتلها، من أجل محاولة استمالتهم، حيث تشمل هذه الوعود تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية، بالتحديد في منطقة “القنيطرة”، وتوظّف إسرائيل العامل الأمني في تعزيز حضورها على مستوى الحاضنة، لا سيما في ظل عدم الحسم في السياسات السورية تجاه التعامل مع الاستهداف الإسرائيلي، بين التصعيد أو الدبلوماسية والإحباط السياسي لدى البنى الاجتماعية في ما يتعلق بالقوة غير المتناظرة، مما يتطلب وضع سياسات حوكمية سريعة، تشمل الأبعاد الاقتصادية والخدمية والأمنية، لأن من شأنها إعطاء مجال أوسع للتركيز على تلك التحديات وعدم ترك ذرائع في الديناميات الداخلية لإسرائيل.
خاتمة:
يشي سلوك إسرائيل بمدى شعورها بالخطر الاستراتيجي من الدولة السورية الجديدة، مع أنّها تدرك المدى الزمني الذي تحتاج إليه سورية حتى تستعيد مكانتها كدولة، وقد يكون هذا الشعور محركًا لما يمكن تسميته “العبث” الإسرائيلي في الأمن القومي السوري الفتيّ، لكنه يبدو غير كاف بالنسبة إلى إسرائيل للتسليم بمعادلة “القوى اللا متنظرة”، أو غير المتكافئة Asymmetric warfare))، في الإقليم وسورية بشكل خاص.
ويمثّل التعدّي الإسرائيلي على السيادة السورية الانتقالَ من القيام بالانتهاك العسكري، ضمن سياسة التصرف المسبق لتهديدات محتملة (Preventive)، إلى محاولة إفشال المسار السياسي والوطني السوري، ضمن المرحلة الانتقالية السورية، أي الاعتماد على نهج “إدارة المخاطر الاستراتيجية”، وفق اعتقادها الذي يفيد بأن سورية “مخطر” قد تشكّل تهديدًا بعد عقود، في حال استطاعت تجاوز مرحلة بناء الدولة.
تحاول إسرائيل إسقاط المشروع السوري الوليد قبل ولادته، أو تحاول على الأقل خلق تحديات تكتيكية له، بغية إبطاء حركته الزمنية. ومن الجليّ أنّ إسرائيل تستخدم كل الكروت المتاحة في المعادلة السورية، حتى الكرت السوري الداخلي “الطائفي”، من أجل تفتيت المجتمع السوري وتعزيز الانقسام، وإبقاء سورية ضعيفة مشتتة غارقة في صراع الهويات الفرعية، بعيدة عن بناء الهوية الوطنية، وهذا ما يجب أن تلفتت إليه الحكومة السورية، عبر نزع كروت الاستثمار، ومعالجة المسائل الداخلية، واستمرار النضال الوطني الإقليمي، كما فعلت قوى الثورة خلال مرحلة الثورة السورية، مع أهمية مراعاة قراءة المرحلة، بأنها مزيج من البناء الذاتي والوطني والدفاع عن الأمن القومي، والاستفادة من السياسيات التي من شأنها تحسين شروط التموضع السوري في الدبلوماسية القسرية.
[1] انظر كتاب سقوط الجولان، لخليل مصطفى، من الصفحة 30 إلى 90.
[2] Netanyahu says Israel will stay in southern Syria ‘for foreseeable future’,Middle east monitor, February 25, 2025, link: https://cutt.ly/OroM4wx1.
[3]مركز حرمون للدراسات المعاصرة، التصعيد الإسرائيلي في سورية مطلع عام 2025: الغارات، الأهداف، والتداعيات، 18 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://cutt.ly/prpsPaDW
[4] مركز حرمون للدراسات المعاصرة، جنوب سورية: التحركات الإسرائيلية والتوازنات الإقليمية، 4 آذار/ مارس 2025، الرابط: https://cutt.ly/3roM0NRq.
[5] SUZAN FRASER AND IBRAHIM HAZBOUN, Turkey and Israel face mounting tensions over future of post-Assad Syria, March 15, 2025, link: https://cutt.ly/5ro1sP20.
[6] In Israel, opposition calls for general strike over security chief dismissal, Le Monde with AFP, 22 Mart 2025, link: https://cutt.ly/droM7pdZ.
[7] Lebanon, Syria could ‘normalise ties with Israel’, US Middle East envoy Witkoff claims, The new Arab, 27 February 2025, link: https://cutt.ly/CroM5nxk.
[8] فاضل خانجي، استحضار صدمة 07 أكتوبر عند التفكير بمستقبل سورية، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 16 أيار/ مايو 2024، الرابط: https://cutt.ly/Uro1iqgG.
[9] Lucy Kurtzer-Ellenbogen, What Assad’s Fall Means for Israel and Its Regional Relations, Thursday, December 19, 2024, link: https://cutt.ly/dro1s84c.
[10] Carmit Valensi, A New Era in Syria: Winners, Losers, and Implications for Israel, January 12, 2025, link:https://cutt.ly/Kro1de7x.
[11] Ksenia Svetlova, Following Assad’s Fall, Do Syria’s Druze Want Israel to Come to Their Aid?, Haaretz, Mar 3, 2025, link: https://cutt.ly/2ro1woSv.
[12] المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سياسة إسرائيل تجاه سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، 9 آذار/ مارس 2025، الرابط: https://cutt.ly/bro1elOZ.
[13] Jo-Ann Mort, Can Trump make a deal for Middle East peace?, The Guardian, 23 Jun 2025, link: https://cutt.ly/Wro1tHBH
[14] Barak Ravid, Scoop: Israel and Jordan held secret talks on Syria, Dec 14, 2024, link: https://cutt.ly/Lro1djEU.
تحميل الموضوع
مركز حرمون
—————————
خطط إسرائيل الخفيّة في السويداء/ دهام العزاوي
1/4/2025
الزيارة التي قام بها وفد ديني درزي إلى إسرائيل في 15 مارس/ آذار 2025 لم تكن سوى الشرارة التي أعادت إشعال المشروع الإسرائيلي لتوظيف الأقليات والجماعات العرقية والدينية في تقسيم المنطقة العربية.
وفي فقه السياسة المجردة، قد تُعتبر هذه الخطوة بداية لإستراتيجية تهدف إلى مزيد من الضغط على حكومة أحمد الشرع، التي باتت تل أبيب تعتبرها تهديدًا مستقبليًا لمشروعها الاستيطاني في المنطقة العربية.
إسرائيل وتحالف الأقليات
أكد منظمو زيارة الوفد الدرزي من السويداء والقنيطرة، أن زيارتهم لا تحمل أي دلالات سياسية، وإنما الغاية تعزيز الروابط بين دروز سوريا وفلسطين والتي انقطعت منذ خمسين عامًا، حينما منع الرئيس حافظ الأسد وابنه بشار الزيارات على جانبي الحدود بين أبناء العمومة في القنيطرة والسويداء وأقاربهم في الجولان المحتل.
ولكن الإعلام الإسرائيلي، ومراكز القوى في إسرائيل ضخّمت الحدث، وسعت إلى توظيفه في إطار السياسة الإسرائيلية القديمة التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعادة تفعيلها تحت ستار (تحالف الأقليات)، حيث أعلن في ضوئها أنه سيتدخل لحماية الدروز ليس في إسرائيل، وإنما في سوريا.
فهل ستشهد المرحلة المقبلة توظيفًا واستغلالًا للدروز ضد وحدة سوريا؟ وهل من الممكن أن تتوسع سياسة إسرائيل نحو جماعات دينية متذمّرة من تغيير النظام في سوريا، كالعلويين، الذين تضرّروا من التغيير في سوريا وفقدوا السلطة، وأعلنوا العداء للنظام كما اتّضح في أحداث السّاحل الأخيرة!
لا شك أن توظيف إسرائيل ملفَّ الأقليات ليس بجديد، فقد أعلنت منذ نهاية السبعينيات عن مشروعها حول تحالف الأقليات في الشرق الأوسط، ونشر الصحفي الإستراتيجي الإسرائيلي أوديد ينون في فبراير/شباط 1982، وثيقة بعنوان “الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينيات”، والتي تستند إلى رؤية مؤسّس الصهيونية ثيودور هيرتزل مطلع القرن الماضي، ومؤسسي الكيان الصهيوني، ومن بينهم بن غوريون، والمتعلقة بإقامة “إسرائيل الكبرى”.
بُنيت هذه الإستراتيجية على تكثيف الاستيطان بالضفة الغربية، وطرد الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، وتهجيرهم بالحرب والتجويع والحصار؛ تمهيدًا لضم الضفة وقطاع غزة لإسرائيل، تمامًا مثلما يحصل الآن في غزة والضفة.
وقد شكلت تلك الخطة حجر الزاوية في رؤية القوى السياسية الصهيونية وبضمنها حكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك في سياسات مؤسستَي الجيش والاستخبارات الإسرائيليتَين.
وفقًا للخطة الصهيونية فإن الأقليات ستكون سندًا أساسيًا للسياسة الصهيونية. إذ إنّ الاستبداد العربي، واحتكار السلطة، وعدم قدرة العقلية العربية على استيعاب الآخر المختلف دينيًا وعرقيًا، ستدفع بالأقليات والجماعات الدينية إلى أن يكونوا حلفاء طبيعيين لإسرائيل، وعلى سياسيي الدولة العِبرية توظيف التذمّر لدى أبناء الأقليات؛ لتمرير سياساتهم في تمزيق المنطقة العربية.
ورغم تبدّل الحكومات الإسرائيلية وحروبها المستمرة حيال الفلسطينيين، وفي لبنان، بقيت هذه الإستراتيجية قائمة، وظلت إسرائيل تتحين الفرصة لتنفيذها في أي لحظة ضعف أو انهيار في النظام الإقليمي العربي.
وقد شكّلت لحظة سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأوّل 2024، فرصة تاريخية لإسرائيل لتنفيذ إستراتيجيتها عبر استثمار حالة الفوضى في الأمن، وانهيار الجيش السوري لقضم مساحات واسعة من الجنوب السوري، وحاولت استغلال الانقسامات الداخلية، وهواجس بعض الجماعات الدينية، لكسب ثقة الدروز والأكراد والمسيحيين والعلويين، فهدّدت بالتدخل لحماية الدروز من النظام الجديد في سوريا.
وحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركيّة، فإنّ إسرائيل تسعى إلى تعزيز قناعات الدروز برفض السلطة السورية الجديدة، والمطالبة بحكم ذاتي فدرالي، وتخطط لضخّ مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
وقد أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل لديها تحالف مع الدروز، وعلينا دومًا مساعدتهم، في حين صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأنّه سيُسمح للعمال الدروز القادمين من سوريا بدخول إسرائيل.
وضمن هذا الخُطة نقلت إسرائيل ما يزيد عن عشرة آلاف سلة غذائية للدروز في السويداء، وبعض القرى المحاذية لحدود إسرائيل.
الدروز والهوية العربية
ينحدر الدروز من قبائل عربية، ولسانهم وعاداتهم عربية إسلامية، ولهم فلسفتهم الدينية وشعائرهم التي يتميزون بها عن بقية الطوائف الإسلامية الأخرى، ويؤكد تاريخهم أنهم ساهموا في غالب المنازلات الوطنية الكبرى ضد الاستعمار في سوريا ولبنان وفلسطين.
ولا يزال التيار العروبي القومي يشكل ثقلًا كبيرًا داخل الطائفة الدرزية، وهذا الثقل التاريخي رسمت معالمه مساهماتهم الفعالة في حركة التحرر والبناء الوطني في سوريا، ولبنان، حيث تقدّمت شخصيات سياسية واجتماعية، لعبت دورًا في تاريخ النضال السوري، مثل سلطان باشا الأطرش، وفارس الخوري، وكمال جنبلاط، ولم تظهر منهم طوال تاريخهم في سوريا أي نوازع انفصالية، وطالما عارضوا المشاريع الصهيونية لتقسيم سوريا.
بيدَ أن سقوط النظام ومجيء حكومة ذات لون إسلامي، والخطاب الذي بثته بعض الجماعات الإسلامية المتحالفة مع النظام، فضلًا عن أثر أحداث الساحل السوري الأخيرة على الأمن المجتمعي، قد انعكس ذلك برسائل سلبية، على واقع الدروز، عبّر عنها رئيس الطائفة الدرزية موفق طريف بتصريحات تعبّر عن مخاوف واضحة من النظام الجديد، وتحديدًا رئيسه أحمد الشرع، حيث قال: إنه لا وفاق ولا توافق مع الحكومة السورية الجديدة التي وصفها بالمتطرّفة ولا يمكن التفاهم معها.
هذا التصريح من أكبر رجال الدين الدروز، فتح الباب لشخصيات درزية طامعة في الظهور إلى إطلاق تصريحات مماثلة، ولكن هذه المرّة بتشجيع التطبيع مع إسرائيل، وهي المرّة الأولى التي يظهر فيها بعض الدروز بصورة المتعاون مع ما كانوا يعتبرونه محرمًا على هُويتهم الوطنية وانتمائهم القومي.
فقد صرّح مالك أبو الخير، الأمين العام لحزب اللواء السوري في السويداء، بأن الزيارة التي قام بها وفد ديني درزي لإسرائيل، هي “تمهيد للعلاقات بين سوريا وإسرائيل”، وأن هذه العملية ستتمّ بشكل تدريجي وتشمل جميع الطوائف، ولن تقتصر على الدروز فقط.
والواضح أن الهيمنة الإسرائيلية على مناطق جنوب سوريا، والتأييد الأميركي لسياسات نتنياهو، سيتركان مساحة لظهور قوى سياسية وشخصيات اجتماعية درزية مؤيدة للسياسة الصهيونية في حماية سكان جنوب سوريا.
وهذا إن حصل فسيكون على حساب الصوت العروبي والتاريخ الوطني للدروز، وهو ما حذّر منه الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، حيث يسعى الاختراق الفكري الصهيوني، إلى استخدام بعض الدروز كإسفين إسرائيلي لتقسيم سوريا والمنطقة العربية تحت شعار “تحالف الأقليات”، وهو المشروع الذي عارضه والده كمال جنبلاط ودفع حياته ثمنًا لذلك.
موقف الحكومة
لا يزال الموقف السياسي الرسمي حيال الإستراتيجية الصهيونية يتسم بالضعف وعدم الوضوح، وربما يعود ذلك إلى انشغال حكومة أحمد الشرع بملفات أخرى تعتبرها أكثر أهمية.
إضافة إلى ذلك، يبدو أن الشرع يفضّل تجنّب أي اهتمام بهذا الملف، حتى لا يمنح إسرائيل ذريعة لتكرار زيارة وفود من جماعات دينية سورية شاردة ومعارضة، مثل العلويين في الساحل، الذين ربما أصبحوا بعد الأحداث الأخيرة أكثر استعدادًا للتعاون مع أي حليف يهدد أو يقوض سلطة النظام الجديد في سوريا.
المطلوب من النظام هو مزيد من الحكمة في التعامل مع جنوح بعض الشخصيات الدينية والإعلامية والاجتماعية التي باتت تؤثر علانية التعامل مع إسرائيل ضد الأمن السوري، ففتح جبهات ثانوية سيكون مرهقًا للنظام، والمطلوب من حكومة الشرع البدء بنهج جديد للتعامل السلمي مع مناطق الأقليات، ومنهم الدروز، عبر إعادة إعمار مناطقهم وتشجيع المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة المدرّة للدخل، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر والهجرة المتصاعدة في مناطقهم.
فمناطق الدروز تشهد هجرات متواصلة إلى خارج سوريا، ولهم جاليات كبيرة في أميركا اللاتينية، ومن الملحّ في هذه الفترة، الإسراع بإرسال وفود حكومية من شخصيات درزية موالية لمناقشة مخاوف السكان من النظام الجديد، والبدء بجملة من السياسات الاجتماعية التي تطمئنّ السكان حول مستقبلهم، مثل فتح باب التطوع لأبناء الطائفة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، والأجهزة الأمنية والإدارية، والقيام بحملة تعيينات لحمَلة الشهادات من أبناء المناطق الدرزية، وإبعاد الأصوات المتشددة داخل المؤسسة السياسية والأمنية السورية، والتي تثير بتصريحاتها وممارساتها مخاوف الدروز وغيرهم من الطوائف السورية الأخرى حول مستقبل وجودها وتمثيلها في الواقع السوري الجديد.
إن مستقبل سوريا واستقرارها السياسي يعتمدان، بلا شك، على ما يعتمده النظام الجديد من سياسات تليق بتاريخها العريق، وحاضرها المعقد.
ينبغي للنظام الجديد أن يكون بمثابة البوصلة التي يلتفّ حولها الجميع، وصولًا إلى الاستقرار والتنمية. وهو ما يتطلب حكمة سياسية بعيدة المدى، تقوم على تعزيز التضامن الوطني، وترسيخ قيم المشاركة والعدالة بين السوريين بلا استثناء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب سياسي عراقي ومؤلف كتاب “العولمة والتدخل الانساني لحماية الاقليات”
———————————-
منظومة دفاعية ومسيرات هجومية.. تركيا تتحرك لإنشاء قاعدة عسكرية قرب تدمر
2025.04.01
” أن تركيا بدأت جهوداً للتمركز في قاعدة “تياس” الجوية السورية المعروفة باسم “تي فور” (T4)، وتستعد لنشر منظومات دفاع جوي هناك، وسط تقارير عن بدء أعمال إنشاءات في الموقع.
وبحسب المصادر، تتفاوض أنقرة ودمشق منذ كانون الأول على اتفاق دفاعي، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، يقضي بأن تتولى تركيا توفير الغطاء الجوي والحماية العسكرية للحكومة السورية الجديدة.
ورغم أن المسؤولين الأتراك سبق أن وصفوا أي وجود عسكري تركي في سوريا بأنه “سابق لأوانه”، فإن المفاوضات استمرت بهدوء، في حين تسعى أنقرة لاستغلال انسحاب روسيا وإيران لسد الفراغ الأمني، وتثبيت الاستقرار في البلاد باستخدام قوتها العسكرية.
وتهدف تركيا أيضاً إلى تصعيد عملياتها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهو أحد الشروط الأساسية التي تضعها الولايات المتحدة لسحب قواتها من المنطقة.
منظومة دفاع جوي ومسيرات
وأكد مصدر أن تركيا بدأت خطوات التمركز في القاعدة الواقعة قرب تدمر، وقال: “سيتم نشر منظومة دفاع جوي من طراز حصار (Hisar) في قاعدة T4 لتوفير الغطاء الجوي، على أن تُعاد تهيئة القاعدة وتوسعتها، مع إنشاء منشآت جديدة، ونشر طائرات مسيرة للمراقبة والهجوم، بعضها بقدرات ضرب بعيدة المدى”.
وأضاف المصدر أن السيطرة على القاعدة ستمنح تركيا تفوقاً جوياً في المنطقة، وتعزز عملياتها ضد خلايا “داعش” المنتشرة في البادية السورية. وتهدف أنقرة إلى إنشاء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تشمل قدرات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للتصدي للطائرات والمسيّرات والصواريخ.
وقال مصدر ثانٍ إن وجود الدفاعات الجوية التركية والمسيرات سيشكل على الأرجح رادعاً لإسرائيل ويمنعها من تنفيذ ضربات جوية في المنطقة.
ورفضت وزارة الدفاع التركية التعليق على هذه المعلومات.
قلق إسرائيلي متزايد
ومنذ انهيار حكومة الأسد في كانون الأول، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على المنشآت العسكرية السورية، وخصوصاً في محيط “تي فور”، حيث استهدفت مؤخراً مدرجات ومواقع استراتيجية في القاعدتين الجوية بتدمر و”T4”.
وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحافة إن أي قاعدة جوية تركية في سوريا “ستقوّض حرية التحرك الجوي لإسرائيل”، مضيفاً: “نعتبر ذلك تهديداً محتملاً ونعارضه بشدة”.
وتدهورت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في عام 2023، ما أنهى فترة وجيزة من التقارب بين الجانبين. وتزايد قلق إسرائيل مع التقارب الحاصل بين تركيا وسوريا، معتبرة إياها تهديداً إقليمياً أكبر من إيران.
وأضاف المصدر الإسرائيلي: “استهدفنا قاعدة T4 مؤخراً لإرسال رسالة مفادها أننا لن نسمح بأي تهديد لحرية تحركنا الجوي”.
وكشف المصدر الأول من “MEE” أن أنقرة تدرس نشر منظومة “S-400” الروسية بشكل مؤقت في “تي فور” أو تدمر لتأمين الأجواء في أثناء عمليات إعادة الإعمار، لكن القرار لم يُحسم بعد، ويتطلب موافقة موسكو.
وفي الوقت ذاته، تجري أنقرة وواشنطن محادثات بشأن رفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة “S-400″، والتي تسببت في استبعادها من برنامج مقاتلات “F-35” عام 2019.
تفكيك المنظومة الروسية
وفي مكالمة هاتفية الشهر الماضي، بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سبل إعادة تركيا إلى البرنامج، غير أن القانون الأميركي يشترط على أنقرة التخلي عن المنظومة الروسية.
واقترح مسؤولون أتراك تفكيك منظومة “S-400” وتخزينها أو نقلها إلى قاعدة تقع خارج الأراضي التركية وتخضع لسيطرتها.
لكن إسرائيل تعارض بشدة أي خطوة تسمح لتركيا بالوصول إلى مقاتلات “F-35″، معتبرة أنها قد تُضعف تفوقها العسكري النوعي في المنطقة.
تلفزيون سوريا
—————————-
===================
======================
الحكومة السورية الانتقالية: المهام، السير الذاتية للوزراء، مقالات وتحليلات تحديث 01 نيسان 2025
تحديث 01 نيسان 2025
——————————
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
——————————
الحكومة السورية… وتثبيت هزائم “الهلال”/ إبراهيم حميدي
إيران حاضرة في كل شيء والتخلص من نفوذها وتركتها، لن يكون مهمة سهلة
آخر تحديث 31 مارس 2025
يروي أحد الوزراء الجدد في الحكومة السورية، أنه عندما غاص في سجلات وزارته، فوجئ بحجم “الملفات الإيرانية” وخطورتها. حال هذه الوزارة كوزارات ومؤسسات كثيرة في سوريا. ملفات وعقود وصفقات ومعلومات وتداخلات وامتدادات تصل أحيانا إلى طهران. توغل في “النظام العميق”، ما يجعل تخلص حكومة ما بعد “نظام الأسدين”، من هذه التركة لن يكون سهلا وسريعا.
مرت العلاقات السورية–الإيرانية خلال العقود الماضية بمراحل تصاعدية مختلفة بعد فوز “الثورة” بالحكم عام 1979. وأمام كل أزمة وامتحان تزداد عمقا عموديا واتساعا أفقيا. في الحرب العراقية-الإيرانية في 1980 انحاز حافظ الأسد إلى الخميني ضد صدام. وخلال الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان في 1982 فتح الأسد الأراضي اللبنانية أمام “الحرس الثوري” لتأسيس “حزب الله”.
وخلال حرب الخليج عام 1990 وقف الأسد ضد رفيقه “البعثي” في بغداد وشارك في حرب تحرير الكويت بعد عام. حتى عندما فاوض الأسد الإسرائيليين برعاية أميركية في عقد التسعينات، أبقى على الحضور الإيراني والتنسيق مع حلفائها في الفصائل الفلسطينية التي عارضت “اتفاق أوسلو” 1993.
لقد حافظ الأسد-الأب على تعاون عسكري وأمني مع روسيا (بعد الاتحاد السوفياتي) والصين وكوريا الشمالية من جهة، وعلاقات سياسية واقتصادية مع الدول العربية من جهة ثانية، لكنه أبقى مع إيران على البرامج السرية للتعاون العلمي في المجالات العسكرية والأمنية والصواريخ.
ومع تسلم الأسد-الابن الحكم في عام 2000، انتقلت علاقة دمشق مع طهران من التحالف والتوازن إلى التماهي مع رأي “المرشد”. ومع خروج الجيش السوري من لبنان في 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري وحرب يوليو/تموز 2006، أصبح النظام السوري ينام ويستيقظ في “الحضن الإيراني”.
النقلة الأكبر حصلت في العقد الأخير، عندما اندلعت الثورة السورية في 2011، بات نظام بشار الأسد تابعا إلى “المرشد” الإيراني و”حزب الله” اللبناني، وبات من أدوات إيران في سوريا، فالقرار في طهران والضاحية الجنوبية والتنفيذ من أذرع إيران في الإقليم، وتحولت سوريا ساحة في معركة النفوذ، وممرا ومعبرا للسلاح والذخيرة والعقيدة من طهران إلى العراق إلى لبنان والقضية الفلسطينية وباقي مناطق الشرق الأوسط.
تحت مظلة التحالف، هناك الكثير في سوريا: ميليشيات تابعة لإيران، ومعسكرات تدريب، وممرات ومعابر سرية، وشبكات تهريب، وشركات الالتفاف على العقوبات، وبرامج أسلحة وصواريخ، ومنشآت عسكرية واقتصادية واجتماعية ودينية، وصفقات اقتصادية ومناطق صناعية، وتنسيق أمني، وبنية تحتية كاملة من البرامج الإلكترونية والخلايا السرية التي انتعشت في البلاد مع تراجع قدرات النظام في العقد الأخير.
حاولت إيران بناء “دولة الظل”، بمنشآتها العسكرية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ومع فتح كل ملف من ملفات الحكومة يظهر حجم التوغل الإيراني في سوريا. في المصالح العقارية هناك الكثير من العقارات مسجلة باسم مؤسسات إيرانية. وفي الأمن والجيش هناك الكثير من لجان التنسيق، وأيضا البنية التحتية للتجسس والتنصت إيرانية.
انهيار النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول، أنهى القسم العلني من “الحضور الإيراني”. وانسحبت الميليشيات والمستشارون وضربت المسيرات والطائرات. لكن القسم الأكبر غير المرئي هو الأخطر. تفكيك شبكات تهريب السلاح والمخدرات وقطع الممرات السرية على الحدود السورية مع العراق ولبنان والأردن. وتفكيك الخلايا والبرامج في بنية النظام السوري.
إيران حاضرة في كل شيء والتخلص من نفوذها وتركتها، لن يكون مهمة سهلة. تحقق قسم كبير، وما تبقى عملية صعبة ومعقدة وستأخذ وقتا طويلا. ولا شك أن إحدى المهمات السرية لحكومة ما بعد “نظام الأسدين” هي التخلص من البرامج السرية. ولا شك أن حجم الترحيب العربي والأوروبي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، هو استعداد لدعمها في استكمال الانقلاب الإقليمي وتثبيت نكسات “الهلال الإيراني” في سوريا والشرق الأوسط.
المجلة
———————————
ما يُسجَّل في هامش ولادة الحكومة السورية/ عمر كوش
01 ابريل 2025
جاء إعلان الرئيس السوري، أحمد الشرع، تشكيل حكومة انتقالية في سورية كي ينهي فترة انتظار عاشها السوريون، وامتدّت ما يقارب 14 شهراً بعد سقوط نظام الأسد. والأهم أن تشكيلها استكمل ركناً أساسياً من أركان السلطة التنفيذية الجديدة، وبالتالي، باتت الأنظار تتوجّه، ليس فقط نحو الخطوات التي ستقوم بها الحكومة، والمهام التي ستنجزها، ومدى تطابقها مع تطلّعات السوريين، بل أيضاً نحو تشكيل مجلس الشعب كي يكتمل الركن الأساس في السلطة التشريعية، ما يعني سدّ الفراغ الحاصل في السلطة، وبدء مرحلة جديدة في تاريخية جديدة، يتوقّف عليها مستقبل سورية، ويأمل السوريون بأن تلّبي تطلعاتهم وطموحاتهم، وتخفّف من معاناتهم الطويلة من كارثية مرحلة الاستبداد.
ما يسجّل في هامش ولادة الحكومة السورية الجديدة، أنها المرّة الأولى التي يشهد فيها السوريون مراسم ولادة حكومتهم مباشرةً، ويعرض الرئيس خلالها برنامج عمل الحكومة، التي اعتُبر تشكيلها بمثابة إعلان لإرادتهم المشتركة في بناء دولة جديدة، كاشفاً أن خطّتها المستقبلية تحمل وعوداً كثيرة، بالاعتماد على عدّة محاور، منها “الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها، وإعادة بناء مؤسّسات الدولة على أساس من الشفافية، ومعالجة القضايا المعيشية، إضافة إلى مواصلة معالجة الوضع الأمني”. إضافة إلى استقطاب الموارد البشرية السورية في الخارج، وإنشاء بيئة استثمارية لجذب الاستثمارات… وسوى ذلك.
إذاً، تسجّل ولادة الحكومة وعوداً كثيرة، تنتظر التنفيذ والتجسيد في أرض الواقع، خاصّة أن التحدّيات الكثيرة التي تواجهها لا تتوقّف فقط على ضرورة إشراك جميع السوريين في إعادة بناء ما خربّه نظام الأسد، بل تتطلّب التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الخصوص. ولذلك تبدو التشكيلة الحكومية وكأنّها محاولة للجمع بين متطلّبات التمثيل الداخلي لمعظم أطياف الشعب السوري، وفي الوقت نفسه مراعاة المطالب الخارجية، وخاصّة التي طرحتها كلّ من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، إذ أرادت السلطة الجديدة إظهار التنويع في تولّي المناصب الوزارية بين شخصيات من لونها الإسلامي، وشخصيات أخرى من التكنوقراط وأصحاب الخبرات، وآخرين ممّن شغلوا مناصب خلال فترة نظام الأسد البائد.
تُظهر النظرة إلى التشكيلة الوزارية إسناد حقائب سيادية مهمّة، ممثلةً بالدفاع والخارجية والداخلية إلى شخصيات من “هيئة تحرير الشام” (يفترض أنها حلّت نفسها)، إلى جانب وزارتي العدل والطاقة، فيما ذهبت بقية الوزارات إلى شخصيات من التكنوقراط وذوي الخبرات والمؤهّلات. ولعلّ تمثيل المرأة الوزاري جاء في حدّه الأدنى ممثلاً بسيدة وحيدة، ما لا يتناسب مع نسبة المرأة في المجتمع السوري، ولا مع أهمية مشاركتها في بناء بلدها، فضلاً عن تضحياتها وأدوارها في الثورة السورية. وكان من غير اللائق التركيز ليس في مؤهلاتها ودورها في خدمة مجتمعات الثورة، بل على انتمائها المسيحي. وفي السياق، جرى التركيز في إبراز تعيين وزراء من المكونات العلوية والدرزية والكردية، بغية الإيحاء بالصفة التمثيلية الجامعة لمختلف المكوّنات المذهبية والإثنية، في محاولة لإرضاء قوى الخارج. مع أن رفض مبدأ المحاصصة لم يمنع أن تضمّ التشكيلة الوزارية وزراء من أطياف سورية مختلفة، لكن ذلك لا يحظى بأهمية كبيرة في النظام الرئاسي الذي حدّده الإعلان الدستوري المؤقت، ومُنح فيه الرئيس سلطات تنفيذية واسعة، بما يمكّنه من القبض على مفاصل السلطة، وإرضاء مختلف التكوينات والأطراف التي يريد تقريبها من حضن السلطة.
لم يقتصر الأمر على المناصب الوزارية فقط، بل حاول وزراء في تقديمهم رؤاهم وخططهم إرسال رسائل تطمئن قوى المجتمع الدولي الفاعلة، من خلال إبراز توجّههم نحو بناء دولة “طبيعية مسالمة، وصديقة للجميع”، وتعتمد على إشادة شراكات اقتصادية والانفتاح، وتبنّي علاقاتها الخارجية وفق “مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل” بين الدول، الأمر الذي يشي بأن السلطة الجديدة تدرك مدى حاجتها للتحاور والتعاون مع مختلف أطراف المجتمع الدولي، وأنها ستسعى جاهدةً من أجل إقناع حكومات الغرب بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية، بوصفها العامل الأساس في استمرار معاناة السوريين من تردّي أوضاعهم المعيشية، والمعيق عمليات التعافي المبكّر ومساعيه، والشروع في إعادة الإعمار، وتكمن أهمية تعليقها أو إزالتها في توفير مقوّمات نجاح العملية الانتقالية في سورية.
ما يسجّل أيضاً أن تشكيل الحكومة الانتقالية جاء تلبيةً لضرورات والتزامات داخلية بالدرجة الأولى، ومواجهة التحدّيات المطروحة، وليس مجرّد إجراء غايته إقناع الغرب برفع العقوبات. وبالتالي، ينبغي على السلطة السورية الموازنة ما بين متطلّبات الداخل والخارج، شريطة عدم الوقوع في فخّ المحاصصة الطائفية والإثنية داخلياً، وفي فخّ الرضوخ لابتزاز قوى الخارج، خاصّة أن الولايات المتحدة تخفي خلف شروطها المُعلَنة لرفع العقوبات شروطها غير المُعلَنة، التي تتمحور حول التطبيع بين السلطة السورية الجديدة وإسرائيل، إذ لم يخفِ مسؤولون أميركيون الربط بين رفع العقوبات المفروضة على سورية والتطبيع مع إسرائيل، عبر عقد اتفاقية سلام مذلّة معها، تتخلّى فيها سورية عن هضبة الجولان المحتلة، وعن أراضٍ أخرى احتلّتها إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، بمعنى قبول مقايضة السلام في مقابل رفع العقوبات الجزئي والمشروط، وبشكل يضمن أمن إسرائيل وتفوّقها عسكرياً، ويؤدّي إلى تجريد سورية من ممكنات أن تكون قوّيةً عسكرياً مستقبلاً.
قد تكون تشكيلة الحكومة محاولةً لتكريس تمثيل مكوّنات المجتمع السوري وفقاً للرؤية التي تحملها السلطة الحاكمة، عبر توفير أولوية الاعتماد على أصحاب الكفاءات في شغل المناصب الوزارية، خاصّة غير السيادية، ومن دون الاستناد إلى منطق الانتماء الإثني والمذهبي، لكنّ الأمر الحاسم داخلياً هو العمل على تأسيس دولة المواطنة والقانون، وعدم سعي السلطة إلى فرض هيمنتها على المجال العمومي، الأمر الذي يقتضي تعديل الإعلان الدستوري بما يتماشى مع توفير مساحات تتيح المجال أمام ممارسة الحرّيات وتنظيم الحياة السياسية للسوريين كافّة.
العربي الجديد
———————————
ماذا يريد السوريون من الحكومة الانتقالية الجديدة؟/ حسن النيفي
2025.04.01
عيد سعيد ونصر مجيد، لعلها العبارة الأكثر حضوراً في نفوس معظم السوريين الذين وجدوا في حلول عيد الفطر هذا العام معنى مختلفاً، بل مغايراً لما سبقه من أعياد، إذ هي المرة الأولى التي يتبادل فيها السوريون تهاني العيد من دون خوف من استهداف الطيران الأسدي وسائر وسائل القتل والإجرام. بل لعلها من المناسبات النادرة والمتميّزة أن يتزامن الاحتفاء بالعيد مع الإعلان عن أول حكومة انتقالية في سوريا بعد تحرّرها من الطغيان الأسدي، علماً أن تشكيل الحكومة كان الاستحقاق الثالث بعد استحقاقين سبقاه، أعني مؤتمر الحوار الوطني (24 – 25 شباط 2025) وصدور الإعلان الدستوري (13 آذار 2025)، فما الذي يريده السوريون من الحكومة التي انتظروا الإعلان عن تشكيلها؟.
لعله من الصحيح أن وجود كيان تنفيذي يتولّى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية بات أمراً ضرورياً، إنْ بالنسبة إلى المواطنين الذين يشعرون بالحاجة إلى حضور الدولة في الحياة العامة، وإنْ بالنسبة إلى السلطة الحاكمة التي تستمد جانباً من مشروعيتها من قدرتها على إدارة الشأن العام، ولكن ما هو صحيح أيضاً أن انتظار عموم السوريين لهذا الكيان التنفيذي (الحكومة) لا يعني التطابق أو التماهي في التطلعات أو المطالب، هذا ما تؤكّده الآراء المختلفة وردّات الفعل المتباينة التي أعقبت تشكيل الحكومة، ولعل هذا ما يجيز التمييز بين آراء شريحتين او أكثر من السوريين.
1 – الجمهور العام : ونعني به عموم المواطنين الذين لم يغادروا البلاد، ولاقوا على مدى السنوات التالية لانطلاقة الثورة السورية معاناة متعددة الأشكال والجوانب من جرّاء تردّي الأحوال الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل نظام الأسد البائد، ولا شك أن هؤلاء ينظرون إلى وجود الحكومة على أنها حاجة (وجودية) باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على وقف حالة التدهور المعيشي والانفلات الأمني والفوضى التي تحكم مفاصل البلاد، وبالتالي فهم يريدون من الحكومة المرتقبة كلّ شيء، بدءًا من الأمن وتحصين الحياة العامة من خطر الاستمرار في الفوضى، مروراً بتأمين المأكل والمشرب ومقوّمات الحياة الضرورية، وصولاً إلى مجمل الخدمات العامة – كهرباء – ماء – تعليم – صحة – إلخ، التي تكاد تكون معدومة في معظم المدن والبلدات والقرى. ولعل هذه الشريحة من السوريين لا تأبه كثيراً بالهوية السياسية أو الأيديولوجية لمن سيعمل ضمن تشكيلة الحكومة، وكذلك لا تعنيها كثيراً مسألة المحاصصات العرقية أو الطائفية أو المناطقية داخل بنية الحكومة، بقدر ما يعنيها قدرة هذه الحكومة على القيام بمهامها بإخلاص وأمانة، فمشروعية الحكومة لدى هذه الشريحة مستمدَّة من مُنجزها المرتقب، وليس من خلفياتها السياسية والأيديولوجية السابقة والمعروفة .
ولا ريب أن ابتعاد هذه الفئة من الناس عن ترف المعايير السياسية إنما ينبثق من يقينهم بأن الأسد الهارب قد ترك البلاد تلّةً من الخراب، وإن جدارة أي سلطة جديدة بقيادة البلاد إنما تكمن في قدرتها على انتشال البلاد من حالة الغرق في الفوضى ومن ثم العبور إلى ضفة الأمان، بما يعني ذلك من قدرةٍ على تحسين الظروف الحياتية للمواطن مع الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة ترابها، ومن ثم التأسيس لعهد جديد تكون فيه حياة الإنسان وكرامته وحقوقه من أولويات الدولة، وبالتالي يمكن الذهاب إلى أن هذه الشريحة هي بالفعل من يطبق المفهوم القائل: لا يهمنا من يحكم، بقدر ما يهمنا كيف يحكم.
2 – الناشطون والساسة والنخب الفكرية والثقافية: لعل اشتراطات هذه الفئة أو معاييرها التي تجعلها ناظما لقبول الحكومة الجديدة تختلف عن الفئة الأولى، إذ إنها لا تنبثق من هاجس وجودي وليد معاناة حياتية ويومية، كون معظم أفراد هذه الشريحة يقيمون خارج سوريا، وإنما تنبثق من معايير سياسية أو أيديولوجية، وربما انبثقت أيضاً من معطى حقوقي أو قانوني ذي صلة بإدارة الدولة، ولعل مجمل مطالب هؤلاء تندرج في الإطار التنظيري لشكل الدولة وضرورة تطبيق مبدأ الشراكة في السلطة والالتزام بأسس العمل الديمقراطي وإطلاق الحريات وما إلى ذلك، وهي اشتراطات وجيهة ومشروعة لو خرجت من صومعة (التنظير المجرّد) إلى حيّز المقاربات العملية والواقعية لما يجري على الأرض، ما يعني أن كثيراً مما تقوله هذه الشريحة من (النخب) السورية هو كلام صحيح في إطاره العمومي ولكنه يحتاج إلى مقاربة أكثر عمقاً وملامسةً للواقع ليتحول من خطاب نظري عائم إلى مقاربة نقدية تبحث عن الحلول ولا تسعى للإعاقة أو التعطيل فحسب، وفي هذا السياق ثمة مفارقات تبعث على الاستغراب من جرّاء بعض المواقف، لعل أحدها موقف العديد من الكيانات (أحزاب – تيارات سياسية) وكذلك الشخصيات الثقافية والسياسية التي كانت طوال السنوات السابقة منخرطة في المسارات التفاوضية مع نظام الأسد (مسار جنيف و أستانا – اللجنة الدستورية) وكانت لا تمانع من التفاوض مع النظام البائد ومشاركته في السلطة تطبيقاً للقرار الأممي 2254 ، في حين أنها ترفض اليوم أي مشاركة أو اعتراف بالسلطة والحكومة الحاليتين باعتبارهما نتاج (اللون الواحد)، فهل كان نظام الأسد نظاماً تعدّدياً مختلف الألوان؟
من جهة أخرى، لا يمكننا تجاهل كثير من التناقضات التي باتت السمة المميّزة للخطاب النخبوي السوري، ولعل أبرزها التشديد في التنظير العام على ضرورة الالتزام بمفهوم المواطنة واعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية لمن يتولى موقع المسؤولية في مفاصل الدولة، إلّا أن هذا الخطاب سرعان ما ينحدر إلى دعوة صريحة نحو المحاصصة العرقية والطائفية وربما العشائرية أحياناً. ربما كانت دعوة المجتمع الدولي، وتحديداً أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إلى ضرورة إشراك كافة المكونات العرقية والدينية في حكم البلاد، نابعةً من التصوّر الغربي للدولة السورية، بل للمواطنين السوريين بأنهم ليسوا أكثر من مجموعة من الأعراق والأديان المتناحرة، وتناحرهم هو الجذر الحقيقي للمشكلة او الحرب في سوريا، وقلّما نظر الغرب إلى قضية السوريين باعتبارها مواجهة بين شعب يطالب بالحرية ونظام إبادة موغل في الإجرام ، ولعل هذه الرؤية الغربية هي المنبثقة من تصوّر (استشراقي) لا يزال هو المَعِين الأساسي للمفاهيم والتصورات الغربية عن القضايا العربية والإسلامية، فهل تسعى النخب السورية إلى استلهام هذا الفهم بغيةَ إعادة إنتاجه من جديد؟
ما هو مؤكّد أن هيئة تحرير الشام التي وصلت إلى السلطة من خلال عملية عسكرية (ردع العدوان) هي من تُمسك بالمفاصل الأساسية للسلطة، بل وتحرص على أن تكون الجهة المسيطرة على جميع روافع السلطة وحواملها، شأنها في ذلك، شأن أي حركة ثورية أو عسكرية تستولي على السلطة بالقوة، ولكنها في الوقت ذاته لم تغلق الباب أمام الآخرين أو أمام من يريد أن يكون شريكاً وفاعلاً في إدارة الشأن العام، ولا أعتقد أن بمقدورها القيام بذلك والحجر على وعي السوريين الذي تجاوز عهود الطغيان والاستبداد، ولكن في الوقت ذاته لن تكون الشراكة هدية جاهزة أو مُنجَزاً مكتملاً ينتظر أصحاب الرغبات فحسب، بل سيكون جديراً بأصحاب العمل الدؤوب والجهد الصادق المخلص، ولعله أيضاً يكون مرهوناً بمزيد من التضحيات.
تلفزيون سوريا
———————————–
الحكومة السورية… دمج محيّر/ عدنان عبد الرزاق
01 ابريل 2025
قلما حظي تشكيل حكومة باهتمام وترقب، محلياً ودولياً، كاللذين نالتهما الحكومة السورية قبل أيام، حين نقلت التلفزات السورية وغير السورية حفل تنصيب الوزراء على الهواء مباشرة، في طقس كرنفالي غير مألوف ومعتاد وبطريقة قسم “خلت من الكتب المقدسة”، وإعلان مشروع الوزير على الملأ. ولهواجس المترقبين، السوريين وغير السوريين، أسبابها المحقة، وربما بعضها غير المحق، الذي يمكن وصفه بالمطلبي غير المنصف لحال سورية المهدمة، أو مجازاً بـ”الكيدي”، بدليل الحكم على الحكومة وانتقاد من تسربت أسماؤهم منها، حتى قبل إعلانها رسمياً، من الرئيس أحمد الشرع ليل السبت.
وأسباب الترقب المحقة كثيرة ومتعددة المستويات، فهذه الحكومة تأخر إعلانها، نحو شهر، عن وعود إدارة الرئيس أحمد الشرع وقت شكلت، إنقاذياً، الحكومة الانتقالية، وهذه الحكومة تحت المجهر، السوري والإقليمي والدولي، لجهة ضرورة تمثيلها شرائح السوريين، المناطقية والقومية والدينية، بعد تلوين قيادة الحكم السوري بعد التحرير، ومنها الحكومة، بلون واحد.
ومنتظرة أيضاً، لأنها بمثابة الاختبار الأخير لصدقية الحكم الجديد وتطبيق خطاباته على الواقع، بعد ما يصفه سوريون بخيبتي الحوار الوطني والإعلان الدستوري، واللذين لم يخلوا من الاستئثار أو الانتقائية بأبسط وألطف الألفاظ. بعدما فشلت، أو لم توفق الحكومة الانتقالية بتسيير أعمال السوريين، بل وأخذ عليها مماسك التعسف وتسريح العاملين بالدولة، بعدما عرف عنها التجريب وعدم التخصص والدراية.
بيد أن الحكومة السورية الجديدة حققت جلّ، إن لم نقل معظم المطالب الداخلية والشروط الخارجية، من تمثيل واسع لمكونات السوريين، ولتغليب التكنوقراط على أعضائها، وغلبة الشباب الحالمين أصحاب المشاريع والتطلعات التي طعموها، بمعرفة وتجارب، إثر إقامتهم خارج البلاد. كما لوحظ الاهتمام بما توجبه الحالة السورية، إن بإحداث وزارة الطوارئ والكوارث أو وزارة الشباب والرياضة. كما استجابت الرئاسة السورية لمطالب الدمج ومخالفة نظام الأسدين البائدين، وقت كانت الحقيبة الوزارية بمثابة مكافأة وعدد الوزراء ينوف على الثلاثين.
إلا أن الدمج كان موضع حيرة واستغراب، لأنه أتى على وزارات، من المفترض أن تتوسع، لا أن تندمج مع غيرها لتقاسمها الاهتمام أو تسرق منها الضوء ومن علمها الأولوية، كما حدث مع دمج وزارتي المغتربين والخارجية، رغم أن نصف السوريين اليوم، بين مهّجر ونازح وتحتاج همومهم ومطالبهم وطرائق عودتهم، ربما لأكثر من وزارة. فكيف لها أن تستطيع، وهي المدمجة مع الخارجية ذات المهام الجسام، ببناء واستعادة العلاقات وتحسين صورة سورية التي شوّهها حكم الأسد الابن، قبل أن يهرب في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
قصارى القول: طاول الدمج الوزارات الاقتصادية ذات الإرث الثقيل من التهديم والخراب، والآمال الجسام المعوّلة عليها، بفترة يرى سوريون، الوزارات المدمجة، قواطر لتنميته وتحسين واقعه المعيشي والخدمي. فدمج وزارة النفط والثروة المعدنية مع وزارة الكهرباء كان محط استغراب ودهشة، لأن تشميلهما تحت مظلة الطاقة غير كاف ومبرر، ربما للدمج.
والأهم، أن الثروات السورية الباطنية، بالبر وتحت مياه البحر، النفط والغاز والفوسفات وغيرها، ملفات كبيرة ومعقدة، فضلاً عن أن التخريب الذي لحق آبار النفط وحقول الغاز والتكالب على ثروات سورية بمياهها الإقليمية، يحتاج ربما لأكثر من وزارة. فيما الكهرباء، وإن كانت تولّد عبر الفيول أو الغاز، فهي قطاع آخر ومستقل، ولحقه ما لحقه من خراب وتدمير، إن لمحطات التوليد وشبكات التحويل، أو لكادره ومستثمريه الذين ناقصتهم سنو الحرب لدرجة الندرة، ما يلزمه تفرّد وزير وتوسيع وزارة، ليعود التأهيل للكادر والنور للسوريين والطاقة للمنشآت، والتي تضعها مطلباً أول، للعمل والاستثمار.
وجاء الدمج الثاني، ربما أكثر غرابة. فأن يتم دمج وزارتي التجارة الداخلية “التموين” والتجارة الخارجية مع وزارة الصناعة، فذاك ما لم يجد لتفسيره سوريون سبيلا. فعدا عن ابتعاد التخصص، وربما تنافره بواقع ما هو معروف عن مطالب التجار تخفيض الرسوم لتزدهر أعمالهم وتزيد أرباحهم، ومطالب الصناعيين الذين يطلبون الحماية ورفع الرسوم، ليتمكنوا، خاصة بحالة كما السورية، من إعادة تأهيل وتعمير المنشآت والإنتاج، قبل أن تفرض عليهم السلع المستوردة، منافسة عرجاء.
عدا هذا التفصيل المهم ووجود استقلالية ومؤسسات منفصلة ببنية الاقتصاد السوري منذ عقود، ثمة دور كبير، وكبير جداً لكلا القطاعين، الصناعي والتجاري، بواقع اقتصادي بائس لم يبق نظام الأسد المخلوع، أية بارقة منه أو أمل عليه، بعد عمدية تهديم ممنهجة للبنى وقصدية تهجير الصناعيين والتجار، لم تستثنيا أحداً. ليكون الدمج، غير المتوقع على الأقل، اختباراً لعمل الوزراء وكيفية إدارتهم لقطاعات واسعة، إن عبر توزيع المهام والصلاحيات للمديرين، أو إحداث مديريات مستقلة تخفف العبء على الوزارة المدمجة، أو حتى باستقلالية من تحت الطاولة وغير معلنة، عبر تعيين معاونَي الوزير، كلٌّ لوزارة.
نهاية القول: على كل ما يمكن قوله من ملاحظات حول حكومة الرئيس أحمد الشرع، إلا أنها امتصت عظيم احتقان من الشارع السوري، من جراء تنوعها واتساع تمثيلها وحسن اختيارها، قبل أن تلقى ترحيباً واسعاً، إقليمياً ودولياً، ليبقى الفصل في عمل وأداء الحكومة على الأرض، رغم الذي تعانيه من واقع مرير على صعيد الموازنة المخصصة والبنى المهدمة ومطالب الشارع ورقابته التي لن ترحم… فهو القيّم على الأداء الحكومي بواقع غياب البرلمان الذي من المنطق أن يسبق تشكيل الحكومة، لطالما هو المشرّع والمراقب لها.
العربي الجديد
——————————
شاعر القبيلة وزيراً للثقافة السورية/ راشد عيسى
تحديث 01 نيسان 2025
ظلّت ابتسامة المرء ملء وجهه، مع شعور عارم بالفخر، أثناء الاستماع لكلمات الوزراء السوريين عند إعلان أول حكومة سورية بعد سقوط المخلوع الأسد.
بدا واضحاً أنه قد طُلب منهم، إلى جانب سِير ذاتية مختصرة، تضمين كلماتهم خطة عمل.
هكذا تتالت الكلمات، من بينها كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي. تحدث الوزير عن قاعدة بيانات، ومصفوفة تحديات، وتحليل أسباب، وتطوير مناهج، وخارطة للتعليم العالي، وصولاً إلى كلمته الذهب: “تعزيز الاستقلالية والحرية الأكاديمية”، و”ما أفسد جزءاً كبيراً من التعليم تَدخُّل السياسة والحزب والأمن”.
ثم وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، وبطولته مع فريقه، على مدى 13 عاماً، لا تخفى. إلى وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، الذي حتى في دعابته عن “تشات ج بي تي” بدا عارفاً تماماً لطريقه، إلى وزراء آخرين. حتى السيدة الوحيدة، الوزيرة هند قبوات، قد نجد في الركاكة اللغوية لكلمتها إضفاء لتنوّعٍ مقبول. طبعاً، فليست الحكاية سوق عكاظ، وإلا كان يجب التوقّف أولاً عند خطأ الرئيس السوري أحمد الشرع نفسه في خطاب القمة عندما رفع المضاف إليه في “وصمة عار”.
ظلّ إذاً مزاجُ السعادة طاغياً، إلى أن جاء وزيرٌ قدّمَ كلامه ارتجالاً، وأعوذ بالله من الارتجال في عالم الخطط والموازنات، ولا شك أنكم تعرفون ذلك النموذج من الحكّائين الذين يعتبرون البراعة والفصاحة في التكلّم من دون ورقة، ومن دون توقّف قدر الإمكان، بغض النظر عن الفحوى.
وما هي إلا لحظات حتى بدا الارتجال نفسه “خطة عمل”، فوزير الثقافة، محمد الصالح، شاعر، يقيم، من حيث الشكل الشعري في عصر انحطاط الشعر (لن ننسبه بالطبع إلى العصر الجاهلي حيث زمن فطاحل الشعر العربي)، بعد آية قرآنية، راح ينشد:
“لقد صُمنا عن الأفراح دهراً
وأفطرنا على طبق الكرامة
فسجِّل يا زمان النصر، سجِّل:
دمشقُ لنا إلى يوم القيامة”
“صمنا”، و”أفطرنا” و”أطباق” كلمات للمطبخ، لا للكرامة، كأن تقول مثلاً “منسف أحلام”، هل تجد في كلمة “منسف” مفردة شعرية تتواءم والأحلام؟ كذلك حين تقترن الكرامة بالأطباق. هذا عدا عن أن العبارة “صمنا وأفطرنا” تحيل فوراً إلى مثل شعبي يفسد الكلام الرفيع “صام وأفطر على بصلة”.
وعدا عن أن البيتين يخلوان كلياً من الشعر، فهما ليسا سوى ضجّةِ شِعر، فعندما تقول: “سَجّل يا زمان النصر”، علينا أن نتوقع أن العبارة التالية مرصودة لنفخ “أنا” الجمهور، والذي سيبادر إلى التصفيق، شيء يشبه أنواعاً من الموسيقى ما إن تحضر حتى تحل الدبكة معها.
بات هذا فارقاً واضحاً بين شعر مِنبريّ وآخر للقراءة. ثق أن بعض الشعر، بفضل إيقاعاته، لا يجري التمعن بمعانيه أصلاً، هو مخلوق ليلعب دور ضربة الطبل، تماماً كما مع طبول الحرب، أو طبول دبكة العرس.
أما عبارة “دمشق لنا إلى يوم القيامة”، وهي فحوى كل كلام الشاعر الوزير، التي راح أناس كثر يتناقلونها على السوشال ميديا، من فم الوزير، أو حتى بألسنتهم، فتُشعرنا بأننا إزاء نزاع حدود، تضعك أمام معادلة واهمة لـ “نحن وهم”، كأننا في خضم حرب بين قومين، قبيلتين، وعلى ما يبدو فإن الوزير يجد نفسه هنا أقرب إلى شاعر قبيلة. ولا نحسب أن الدولة الحديثة التي يحلم بها السوريون سيكون شاغلها “نحن وهم”.
عندما نصل إلى خطة الوزير في وزارة الثقافة سيكتفي بتلخيصها، ارتجالاً أيضاً، على أنها أمران: “أنْ نُفتّت ونبتعد عن كل المنظومة الثقافية التي كان يتبناها الوضيع، البائد، محتل هذا القصر”، والركون إلى “ثقافة عمل الخير، الإحسان، ثقافة التآخي،.. “، ويزيد شرحاً: “لا يمكن أن نذهب إلى ترف المعرفة في وقت تسود فيها الحاجة، ويسود فيه البؤس”! لماذا أنت هنا إذاً معالي الوزير؟! فما دامت المعرفة، والثقافة، ترفاً فلنوزّع هذه الحقيبة على “الشؤون الاجتماعية والعمل”، ووزارة الطوارئ، أو الأوقاف، فهذه أقدر على افتتاح تكايا وموائد قد ينتفع الناس بها أكثر من ترف المعرفة.
علينا أن نتوقع إذاً أن حاجات الناس ستكون دائماً في الميزان، وسيقال إن الخبز أهم من الأوبرا، وحطب المدافئ أجدى من رسم المناظر الطبيعية، وإصلاح شبكة الكهرباء أبدى من أفلام السينما،… لكن لا شيء أولى، غالباً، من شعر الوزير.
وفي الواقع، فإن شعر الوزير ضعيف للغاية (حبذا لو تعود إلى نزار قباني ومحمود درويش إن أردت أجمل الأوصاف لدمشق)، وقد انتشر فيديو له، يبدو أنه أعد تحت إشرافه، وواضح فيه الرغبة الهائلة بسقاية “الأنا” بتسليط ضوء استثنائي، وكان يكفيك لو أردت أن تنصرف إلى كتابة شعر أرفع قليلاً من القافية المبتذلة التي تنتهي بـ “ات”، مثل ابتسامات، وذاتي، ياسمينات، ملذات، سماوات، مولاتي، بريئات، ضحكاتي،.. قوافٍ تخجل القلب حقاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوزير.
ولكن ما هي مؤهلات هذا الشاب، حتى يشغل مكانة وزير ثقافة لبلد ناسُه “في جيناتهم حضارة ثقيلة جداً”، على ما يقول هو نفسه في فيديو لاحق من مسجد في ضاحية قدسيا؟
في السيرة الذاتية، كما قدّمها، وبحسب البحث على الشبكة، لا كتب، ولا مؤلفات، ولا مشاريع، سوى عمله في قناة “الجزيرة”. مذيع ببضعة برامج وحسب. وهذا حقاً باب يجب أن يفتح للنقاش وإعادة النظر، فهناك سوء فهم كبير، حيث من البديهي أن يكون المذيع في الضوء، هو الموجود على الشاشة أمام الملايين، ولكن هل مجرد الظهور هذا يؤهله ليصبح من قادة الرأي؟ يتكاثر هؤلاء بشكل لا يردّ، تتكاثر الفضائيات والقنوات التي يطل عبرها مذيعون، فيفتتح الأخيرون دكاناً على تيك توك، أو أيّ من منصات التواصل ليخبرونا بآرائهم وتحليلاتهم، حتى تسللوا بفضل سطوتهم التلفزيونية إلى زوايا الصحف، محتلين أعمدة كبار الكتّاب، وبحكم شهرتهم التلفزيونية باتوا هم الأكثر قراءة.
لا ندري إن كان محمد صالح، مذيع “الجزيرة” الذي احتل موقع وزير الثقافة، يعرف شيئاً عن حال الثقافة في بلده، هل لديه فكرة عن حال مؤسسة السينما؟ ما أُنتج من وثائقيات خلال الثورة أو قبلها؟ هل يعرف شيئاً عن وزارة الثقافة التي هو قادم إليها؟ ما أنتجته وما مرّ عليها من أسماء مثقفين؟
نأمل أن يدعى الوزير غداً إلى نقاش مفتوح مع المثقفين والمشتغلين في مجال الثقافة، عسى يعدّل في خطّته المرتجلة، وقد يلاحظ صعوبة أن يكون المرء مهندساً للثقافة في بلدِ “الحضارات الثقيلة”، وأن عدة الشغل التلفزيوني وبرامج “الفصاحة” ليس لها مكان هنا.
* كاتب من أسرة “القدس العربي”
القدس العربي
——————————–
الشرع يرد على الانتقادات لتشكيل الحكومة السورية الجديدة/ عدنان علي
01 ابريل 2025
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الحكومة الجديدة راعت “تنوع” المجتمع السوري، بعيداً عن “المحاصصة”، مقراً في الوقت ذاته خلال كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر بقصر الشعب في دمشق، يوم الاثنين، بصعوبة “إرضاء” الجميع، في رد ضمني على انتقادات طاولت تركيبة الحكومة التي تولى مقربون منه أبرز حقائبها.
وأضاف الشرع: “سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء… وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات وراعينا أيضاً تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة” في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها. وأضاف “اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة ومن دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين”، بحسب “فرانس برس”.
وأقر أنه “لن نستطيع أن نرضي الجميع”، موضحاً “أي خطوات سنأخذها لن تحصل على التوافق وهذه الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق بالحد الأدنى وبالمستطاع”، معتبراً أن بلاده أمام “طريق طويل وشاق” لكنها تملك “كل المقومات التي تدفع إلى نهضة هذا البلد”.
وأعلن الشرع ليل السبت تشكيل حكومة من 23 وزيراً، من دون رئيس للوزراء. ورغم أنها جاءت أكثر شمولاً من حكومة تصريف الأعمال التي سيّرت البلاد منذ إطاحة حكم بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن تشكيلها أثار انتقادات أبرزها من الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت “مواصلة إحكام طرف واحد السيطرة” على الحكومة، وقالت إنها لن تكون “معنية” بتنفيذ قراراتها.
استعداد أوروبي للتعاون مع الحكومة السورية
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس ومفوّضون آخرون في بيان، إنّ “الاتحاد الأوروبي مستعدّ للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها”.
وقبل ذلك، رحبت إيطاليا بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سورية. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على منصة “إكس”: “أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، إيطاليا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سورية ودعم انتقال سلمي وشامل ومحترم لجميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة”.
كما رحبت وزارة الخارجية الإسبانية بالحكومة الجديدة، التي قالت إنها “قد تمثّل خطوة إلى الأمام نحو الوصول إلى سورية سليمة وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها”.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن إسبانيا ستواصل دعمها للشعب السوري، عبر التنسيق مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة للمساهمة في استقرار سورية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
من جهتها، قالت السفارة البولندية في دمشق، إن “بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سورية، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سورية ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها”.
العربي الجديد
——————————
انتهت الثورة… وداعاً يا أصدقاء/ عمر قدور
الثلاثاء 2025/04/01
في وقت متأخر من مساء السبت بدأت مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية، والتي يُفترض أنها الحكومة الانتقالية. على صعيد الشكل، هي المرة الأولى التي يتقدّم بها الوزراء بإيجاز عن خطة كلّ منهم لوزارته، وكانت هذه فرصة للتعرّف عليهم وعلى التباينات فيما بينهم. إذ ظهر مَن هو مدرك جيداً للإحاطة المطلوبة منه، وظهر مَن تعامل معها كمناسبة خطابية تعفيه من تقديم تصور أولي عن عمله المقبل.
لكن حتى هذا الأخير لقي تهليلاً واسعاً لدى أنصار السلطة، وزاد تهليلهم نكايةً بانتقادات الذين أشاروا إلى فداحة عدم تقديمه ما يشي بمعرفته بالوزارة التي يترأسها. النقد ممنوع لدى هؤلاء الأنصار، وبحجج صارت معروفة مسبقاً. بل يمكن تصوّر ردود الأفعال برمّتها (قبل حدوثها) على نحو يبدو كاريكاتورياً، مع أنه ليس كذلك، حيث هناك شريحة واسعة مستعدة سلفاً للتهليل.
في المقابل، ثمة فئة ضيقة من الذين يرفضون السلطة جذرياً، بمعنى أنهم يرفضون الاشتباك معها على صعيد التفاصيل ولو من موقعهم الرافض نفسه. وليس في المنتصف بين النقيضين، بل على حدة، هناك الذين يتعاطون من منظور السياسة، بوصف الأخيرة اشتباكاً بالواقع على صعيد الكليات والجزئيات. وأيضاً بوصف السياسة وسيلة للتشارك في الفضاء العام، من دون إقصاء ومن دون السماح لأية جهة بالتغوّل عليه.
جدير بالذكر أن إعادة السياسة إلى التداول كانت من بين المقاصد الأساسية لثورة 2011، ويبدو هذا الجانب غائباً أو مغيَّباً عن معظم سجالات اليوم القائمة على اصطفافات أرسخ من أن تُحسَب على السياسة. الثورة حسب أنصارها انتهت على أبعد تقدير مع سقوط الأسد، وهي بحسب آخرين انتهت قبل ذلك بسنوات طويلة لصالح الحرب وانقساماتها. الثورة انتهت، بعد شهور بالنسبة للبعض، وبعد سنة أو اثنتين بالنسبة للبعض الآخر، وعندما دخل الشرع دمشق بالنسبة لآخرين. المهم أن ثورة 2011 قد انتهت، ولا توجد ثورة أخرى الآن، وهذا ما يجب التأكيد عليه، والانتباه جيداً إلى مضمونه.
معظم المنخرطين في سجالات اليوم لا يزال ماثلاً في أذهانهم انقسام ثورة 2011 ثم انقسام الحرب التي تلتها، وهو بطبيعته انقسام جذري لأنه استقرّ بوصفه انقساماً دموياً لا رجعة فيه. وعلى ذلك لم يخضع للتفحّص والتمحيص، رغم أن العديد من انحيازات الحرب كان محكوماً بالضرورة والإكراه، لا برغبات حرة، وأبسط مثال على ذلك هو الانحياز إلى فصائل لا تلبّي التطلعات، لكنها كانت مقبولة لأنصارها بالمقارنة مع العودة إلى جحيم الأسد. والعداء المستحَق للأخير وحَّدَ طيفاً واسعاً من المتخالفين، ونسبة منهم لا تؤمن بالمُثُل التي نادت بها الثورة، ومن ضمنها نسبة غير ضئيلة من الذين يعتقدون أن الثورة قامت لأن الأسد ارتكب المجازر، أي بوصفها ردّ فعل لا غير.
القسم الأكبر من السوريين لا يعلم الكثير عن النضالات التي تصاعدت في النصف الثاني من السبعينات، وانتهت بقمع شديد من الأسد الأب. ثم عادت الحيوية رويداً رويداً في التسعينات، لتكون مع بداية القرن أكثر وضوحاً في تبنّي قيم الحرية والديموقراطية. انطلاق الثورة، بهذا المعنى، هو من ضمن سياق سوري فلا يُفسَّر فقط بموجة الربيع العربي. وعندما نقول إنه سوري فالحديث هو عن سياق من السعي إلى التغيير الديموقراطي، السياق الذي لم يبدأ بالثورة ولم ولن ينتهي بانتهائها.
وفق السياق ذاته، تثبت السلطة انتماءها إلى الثورة بأن تيسّر السياسة كسبيل إلى التحوّل الديموقراطي، فلا يُضطر السوريون إلى ثورة جديدة؛ هذا لا يخص السلطة الحالية فقط بل يصح لو كانت مكانها أية سلطة أخرى. الثورة هي بنت الضرورة، وهي الاستثناء لا القاعدة، وهي مكروه بقدر ما يكون الثمن المدفوع غالياً، وهذا المكروه لا ينفي الاعتزاز بقيَمها.
يُبنى على ذلك أن انقسامات الثورة هي أيضاً الاستثناء لا القاعدة، وجذرية الانقسام استثناء آخر، بينما القاعدة هي الانقسامات السياسية المتولّدة عن مصالح ورؤى مشتركة لأطرافها ضمن صراع سلمي. وعندما نقول إن الثورة انتهت فمن المفترض تالياً أن تنتهي انقساماتها لصالح انحيازات جديدة للسوريين؛ انحيازات سياسية بمعنى أنها تتوسل السياسة كأداة للاختلاف، ولا تتوسل العنف حتى في حالات الخلاف الراديكالي، ولا يسعى أي طرف إلى إسكات الخصم والقضاء عليه قضاء مبرماً على غرار ما آل إليه الصراع مع الأسد كصراع وجود.
اليوم، هناك قدر كبير من العنف اللفظي بين السوريين على السوشيال ميديا، عنف يذكّر ببدايات الانقسام على خلفية الثورة، وهو بمعظمه صادر عن أولئك المؤمنين بأنها انتصرت. هذه المفارقة يفسّرها عدم استقرار فكرة الانتصار في نفوسهم، أو عدم فهمهم لمغزى الانتصار الذي يؤذن باستهلال السياسة كساحة اختلاف لا كميدان للإقصاء. يزيد من حدة العنف بروز انقسامات ضمن أبناء “الخندق الواحد”، بعدما استكان أبناء الخندق إلى تشاركهم فيه وكأنه من البديهيات التي لن تخضع للتغيير.
أسوأ ما في الأمر أن التعبير عن الخصومات المستجدة يُمارس بالطريقة ذاتها الخاصة بانقسامات الثورة، وبالمفردات ذاتها، وهذا دليل إضافي على أن انقسام الثورة غير قابل لإنتاج معنى مشترَك جديد مواكب لانتهائها. في الأصل يلزم الاعتراف بأن رفقة الثورة والحرب هي مؤقتة، وليست ارتباطاً كاثوليكياً، والاعتراف كفيل بأن يدفع الشجاعة العاطفية قدُماً من أجل الانفصال والقول: وداعاً يا أصدقاء. وإذا كان تحوّل بعض أصدقاء الأمس إلى خصوم اليوم محزناً على الصعيد الوجداني، فمن المؤسف ألا يكون متوقعاً، وأن يكون صادماً على صعيد الوعي.
لقد أظهرت السلطة وعياً أعلى من أنصارها في التموضع الجديد، من خلال التشارك مع رجال من العهد البائد بمن فيهم وزراء في الحكومة الجديدة، وهي تعرف الذين تتشارك معهم، فلا تحتاج إلى متطوّعين لتتنبّه إلى سجل هؤلاء. أغلب الظن أن الجمهور القليل الواعي لمصالحه مع السلطة غير متفاجئ بشراكاتها، المشكلة هي في الجمهور الذي تفاجئه السلطة بذلك، وهذا مكوّن من شريحة واسعة من غير الواعين لمصالحهم؛ الذين هم خارج السياسة فعلياً بينما يظنون أنهم منشغلون جداً بها.
قد تكون هناك حاجة لمزيد من الوقت كي ينقسم السوريون على أساس تحالفات سياسية جديدة، لأن المصالح الجيدة لم تتبلور وتنضج بعد. الأكيد أن تحالفات الثورة والحرب انتهت، والتأكيد هنا ضروري ليُعاد الاجتماع السوري على نحو أرحب. الأكيد أيضاً أن قطار التغيير الديموقراطي لم يصل محطته الأخيرة، وأمامه العديد من المحطات التي سينزل فيها البعض ويصعد منها البعض الآخر، ولن يندر أثناء سيره أن يُرمى بالحجارة.
المدن
————————
رسائل الحكومة السورية الجديدة ليست كافية/ بسام مقداد
الثلاثاء 2025/04/01
كان الكل ينتظر تشكيل الحكومة السورية الجديدة، ويتوقع منها الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي لا تزال تحيط بالسلطة الجديدة. لكن تشكيلة الحكومة جاءت لا لترد على الأسئلة، بل لتعبر عن هواجسها بتوفير ضمانات استقرارها. وأظهرت أن السلطة متمسكة بتوجهها الذي يضع على رأس أولوياتها توفير ضمانات ترسيخ مرتكزات وجودها، وليس الرد على الأسئلة الكثيرة التي يطرحها الآخرون، وخصوصاً في الخارج، حول مدى انفصالها عن تاريخها كمنظمة مدرجة على قوائم الإرهاب في العالم.
يرى البعض أن تشكيل الحكومة الجديدة حمل عدة رسائل يمكن حصرها بثلاث، موجهة بالدرجة الأولى إلى الغرب، الذي يتريث في رفع العقوبات كلياً التي فرضت على نظام الأسد المخلوع، وإلى المحيط الذي لم يتخطَ بعد الشكوك التي تساوره بشأن طبيعة النظام الذي ستستقر عليه السلطة الحالية. والرسالة الأولى التي يحملها تشكيل الحكومة تمثلت في تنفيذ الوعد الذي قطعته السلطة على نفسها بإنهاء المرحلة المؤقتة في آذار/مارس المنصرم. والرسالة الثانية تمثلت في التنوع الديني الإثني في تشكيلة الحكومة، حتى ولو لم تتمثل فيها “قسد”. والرسالة الثالثة تمثلت في ما أعلنه الشرع من أن تشكيل الحكومة الجديدة يعلن القطع النهائي مع سوريا السابقة وصراعاتها، وبدء مرحلة التغيير وبناء دولة المؤسسات.
لكن السؤال يبقى ما إن كانت الحكومة الجديدة توحي للأطراف التي تم توجيه الرسائل إليها بالثقة وبأن المعلن يتطابق مع المضمر، وأن حرية الفرد الشخصية وحقوقه سيتم الإلتزام بصونها وعدم طغيان الأيديولوجية عليها.
انبثقت الحكومة الجديدة من الإعلان الدستوري المؤقت الذي منح الحكومة الصفة الدستورية، والتي أرادتها وصاغت دستورها السلطة نفسها. فكثيرون يعتبرون أن التنوع الديني والإثني المنقوص الذي تميزت به الحكومة الجديدة، هو تغيير شكلي لم يغير من جوهر الحكومة المؤقتة السابقة.
فقد رأى kirill Cemenov الخبير في شؤون الشرق الأوسط بالمجلس الروسي للعلاقات الدولية RIAC في تواصل “المدن” معه، أن مجرد تشكيل حكومة جديدة لا يمكن أن يكون دليلاً على استقرار النظام الجديد. وقال إن الحكومة الجديدة لا تختلف عن السابقة بشيء وليست شاملة. وتشكيلها أقرب إلى إجراء بيروقراطي روتيني منه إلى رسالة موجهة إلى دول الشرق الأوسط.
ورأى أن استقرار النظام يمكن الحكم عليه من خلال إجراء انتخابات في سوريا. والمسألة تكمن في مدى فعالية الحكومة الجديدة. إذ أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية قد تدفع السوريين قريباً إلى التخلي عن دعم السلطة الجديدة.
المتابع لشؤون الشرق الأوسط Igor Subbotin في صحيفة NG الاتحادية الروسية، لم يكن فيما أدلى به لـ”المدن” على هذا القدر من التشاؤم بشأن الحكومة السورية الجديدة. بل رأى في تشكيلها “محاولة واضحة” من قبل السلطة لإقناع الغرب بإلغاء العقوبات. كما رأى بأن التنوع الديني والإثني في الحكومة الجديدة، كان ضرورياً لدعم محاولة الإقناع هذه. إلا أنه يشير إلى عدم تمثيل “قسد” في التشكيلة الحكومية الجديدة، على الرغم من وجود كردي دمشقي فيها، لا يساهم في دعم محاولة الإقناع هذه . وقال إن غياب “قسد” يشير إلى استمرار وجود خلافات مع سلطة دمشق، على الرغم من الاتفاقية التي تم التوقيع عليها سابقاً. ووجد في ما نشرته “المدن” عن تأجيل إعلان الحكومة بسبب المفاوضات مع “قسد” دليلاً إضافياً على وجود هذه الخلافات.
ويرى أن دعوة وزير الاقتصاد الجديد نضال الشعار المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، تشير إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يبدو محاولة تهدئة كل المخاوف وحث المجتمع الدولي على إلغاء العقوبات.
وأشار الصحافي إلى أن الرسمييين الأميركيين والأوروبيين، الذين تنقل عنهم صحيفة الواشنطن بوست، يعلنون بأنهم يتابعون بدقة مدى إلتزام الشرع بمبدأ الشمولية، وذلك من أجل البحث في إمكانية تحرير سوريا من العقوبات الغربية. لكنه رأى أن ليس من إشارات تدل على أن العقوبات سترفع في الفترة القريبة. ولتحقيق هذه الغاية، تطرح الدول الغربية مروحة واسعة من الشروط على سوريا، بما في ذلك تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية القديمة والتعاون في مكافحة الإرهاب. هذا إضافة إلى المطلب الخاص بضمان أمن الأقليات الدينية والإثنية. ويستشهد بتصريح الناطقة الصحافية بإسم الخارجية الأميركية تامي بروس، الذي أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة تتابع أعمال الحكومة السورية المؤقتة لكي تحدد سياستها المقبلة حيال سوريا. لكنها أضافت بأن دينامية العقوبات لا تتغير، وليس هناك في المرحلة الراهنة مخططات لتغييرها، “بل هي ستبقى”.
الصحافية Marianna Belenkaya التي كانت حتى فترة قريبة تتابع شؤون الشرق الأوسط في إحدى كبريات الصحف الروسية Kommersant، قالت لـ”المدن” إنه على الرغم من تشكيل حكومة سورية جديدة، من المبكر الحكم على استقرار نظام الشرع. فلا تزال السلطات في دمشق تعاني من العديد من المشاكل الداخلية التي لم يتم حلها. لكن الشرع يحاول في الوقت الراهن أن يثبت أن سوريا جاهزة للتغيير وأنه يسيطر على الوضع. ومن المهم أيضًا أنه لا ينوي التخلي عن السلطة، وهو يشغل منصبين في الوقت نفسه، رئيسًا للسلطة ورئيسًا للوزراء. والزمن كفيل بإظهار كيف سيتعامل مع الأمر.
وكالة الأنباء الروسية REX نشرت في 30 المنصرم تقريراً عنونته بالقول “إلى متى ستصمد الحكومة الجديدة في سوريا؟”.
بعد تقديم مختصر للنص، نقلت الوكالة عن الكاتب السياسي في الوكالة عينها Stanislav Tarasov تقييمه لتشكيل الحكومة السورية الجديدة. أشار الكاتب إلى قول الشرع في إعلانه عن تشكيل الحكومة إن مرحلة جديدة تبدأ في تطور سوريا. وقال إنه لأول مرة منذ 60 عاماً، أصبحت البلاد تمتلك حكومة من دون حزب البعث. وقد ألغى الإعلان الدستوري المؤقت مؤسسة مجلس الوزراء، وأنشأ نظاماً رئاسياً، وبالتالي لم يعد من الممكن في سوريا الحديث عن حكومة بالمعنى المؤسساتي، بل عن فريق وزراء يرأسه رئيس، وهو ما جذب اهتماماً متزايداً من قبل المسؤولين الأميركيين والأوروبيين. وسبق أن كان هؤلاء يشددون على تشكيل ما يسمى بالحكومة الشاملة، التي كانت تعتبر شرطاً على السلطة الانتقالية تنفيذه، من بين شروط أخرى، لرفع العقوبات عن سوريا.
توقف الكاتب عند الشخصيات الثلاث في الحكومة التي لم تكن في صفوف معارضة النظام المخلوع. وأشار إلى يعرب بدر الذي عاد وشغل منصب وزير النقل الذي سبق أن شغله بين العامين 2006 و2011. ونضال الشعار الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد الذي شغله سابقاً لمدة عام فبل إنطلاق الثورة. وكذلك وزير التعليم الحالي محمد تريكو الذي سبق أن شغل منصب نائب رئيس جامعة دمشق. وهو الكردي الوحيد في التشكيلة الحالية، لكنه لا يمثل “قسد” أو أي حزب كردي آخر.
وقال الكاتب بأن التمثيل النسائي اقتصر على مقعد وزاري واحد شغلته إمرأة مسيحية. ويرى أن المشكلة الأكبر في التمثيل المناطقي تمثل في عدم تمثيل محافظة درعا التي توصف بأنها “مهد الثورة السورية”، في حين أن محافظة دير الزور حصلت على ثلاث حقائب.
المدن
————————-
الحكومة السورية الجديدة.. إعادة الإعمار فوق المنصة/ مصطفى ديب
1 أبريل 2025
منذ أعلنت الرئاسة السورية عن التشكيلة الحكومية الجديدة، ليل السبت – الأحد، لا يزال التفاعل مستمرًا في الأوساط السياسية والشعبية، بين من رأى فيها خطوة تنظيمية مطلوبة، ومن رأى فيها إعادة إنتاج للخطاب القديم بصيغة جديدة.
طُرحت خلال المؤتمر وعود طموحة ومشاريع كبيرة، أظهرت كلمات العديد من الوزراء فجوة واضحة بين التصورات المعروضة والواقع الميداني المعقّد الذي تعيشه البلاد.
في هذا التقرير، نعيد قراءة أبرز ما طُرح من مشاريع وخطط حكومية، ونقارنها بمدى واقعيتها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الراهنة في سوريا.
انطلق المؤتمر، في قصر الشعب بدمشق، بكلمة ألقاها الشرع أوضح فيها مهام الحكومة الجديدة، وأشار من خلالها إلى إلغاء بعض الوزارات، ودمج أخرى، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة تحت مسمى “الطوارئ والكوارث”، تولى حقيبتها الرئيس السابق للدفاع المدني “الخوذ البيضاء”، رائد الصالح.
وعلى مدار ساعة ونصف، عرّف الوزراء بأسمائهم، واستعرضوا خططهم ومشاريعهم قبل أداء القسم أمام الرئيس الشرع. بدت كلمات بعض الوزراء منفصلة وبعيدة عن الواقع، حيث أطلق معظمهم وعودًا ضخمة ووعدوا بمشاريع مستقبلية بعيدة المنال، إذ لا تستند إلى أي أسس واقعية من جهة، ولا تراعي مدة ولاية الحكومة المحددة بخمس سنوات، من جهة أخرى. وذلك عدا عن التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه سوريا، خاصةً في ظل استمرار العقوبات الغربية.
وفيما بدت كلمات بعض الوزراء محاولة لتقديم صورة إيجابية للحكومة محليًا ودوليًا، من خلال التركيز على خلفياتهم الأكاديمية ومؤهلاتهم العلمية بكثافة؛ بدت كلمات وزراء آخرين منفصلة عن الواقع، وتعكس عدم معرفتهم بحقيقة المشاكل التي يعاني منها السوريون على الأرض، ومدى صعوبة الوضع الإنساني والمعيشي الذي يزداد سوءًا.
وعود كبرى ومشاريع ضخمة
قال وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، إن الوزارة ستعمل على تطوير المناهج الدراسية، وتحسين جودة التعليم، وتشجيع البحث والابتكار والإبداع العلمي.
وعلى الرغم من أنها أهداف وضرورية، لكنها تتجاهل عدم وجود بيئة تعليمية مستقرة نتيجة ما لحق بالقطاع التعليمي من خراب على مدار 14 عامًا بما في ذلك تدمير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وما يواجهه المعلمون والطلاب من ظروف معيشية قاسية تدفع كثيرين منهم إلى ترك مقاعد الدراسة والعمل في مهن شديدة القسوة.
وقدّم وزير الطاقة محمد البشير مثالًا آخر على مدى الفجوة بين تصريحات الوزراء والواقع الراهن، إذ بدت وعودته بتطوير البنية التحتية للطاقة وبناء منشآت حيوية، وتأهيل وصيانة شبكات وخطوط المياه والكهرباء؛ كأنها صادرة عن وزير في دولة متقدمة تتمتع بقدرات مالية ضخمة.
وتثير وعود البشير الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذها، خاصةً أن معظم آبار النفط في سوريا تقع في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، عدا عن أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة، ما يمنع الدول والشركات التي تعتزم الاستثمار في سوريا من اتخاذ هذه الخطوة، الأمر الذي ينزع مصداقية وعوده ببناء شراكات إقليمية ودولية في مجال الطاقة.
وبدت تصريحات وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، الأكثر بُعدًا عن الواقع، إذ تحدث عن مشاريع ضخمة تشمل إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة، والانتقال نحو بناء حكومة رقمية؛ وذلك في وقت تعاني فيه سوريا من الانقطاع المتكرر للكهرباء، وضعف خدمات الإنترنت، والدمار الهائل الذي طال البنية التحتية في قطاع الاتصالات، عدا عن أن مثل هذه المشاريع تتطلب تمويلًا ضخمًا غير متوفر حاليًا.
وعكست وعود وزير الزراعة، أمجد بدر، مستوى آخر من الانفصال عن الواقع، إذ أغفل في حديثه عن الواقع الزراعي في أن معظم الأراضي الزراعية تعرضت للتخريب بسب الحرب، أو مليئة بالألغام، أو تخضع لتفاهمات معينة بين قادة بعض الفصائل. كما بدا حديثه عن تحقيق الأمن الغذائي بعيدًا عن الواقع في ظل الأزمة الإنسانية الضخمة التي يعاني منها أكثر من نصف الشعب السوري.
وفيما يبذل النازحون والمهجرون جهدًا هائلًا من إجل العودة إلى قراهم وبيوتهم؛ تحدث وزير الأشغال الإسكان مصطفى عبد الرازق عن إنشاء بيئات عمرانية مستدامة، وذلك في بلد تبلغ تكلفة عملية إعادة إعماره بين 150 إلى 300 مليار دولار أميركي. ومع أنه أشار إلى دور الوزارة في إعادة الإعمار، إلا أن ذلك مر بشكل عابر، دون توضيح ماهية هذا الدور الذي تعتزم تأديته.
وتراوحت وعود وزير النقل، يعرب بدر، بين الكلام العام والانفصال عن الواقع، إذ تحدث عن تطوير النقل، واستعادة الربط الإقليمي، والتحول إلى النقل المستدام الصديق للبيئة؛ بينما البنية التحتية الأساسية مدمرة، والطرقات تحتاج إلى إعادة تأهيل، وكل ذلك يحتاج إلى مواد مالية غير متوفرة.
وعكست كلمة وزير السياحة، محمد ياسين الصالحاني، نوعًا من الجهل في فهم مهام الوزارة التي حددها بـ”الضيافة”، متجاهلًا أن السياحة تُعد قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا حيويًا، خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج فيها البلاد إلى ما يساهم في إعادة بناء اقتصاديها.
الترا سوريا
——————————
في سوريا الجديدة.. ضعف التمثيل النسائي في حكومة المرحلة الانتقالية يثير الجدل/ وائل قيس
31 مارس 2025
أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن تشكيل الحكومة السورية التي ستتولى إدارة شؤون البلاد خلال السنوات الخمس القادمة. وقد حظيت “هيئة تحرير الشام” بأكبر حصة تمثيلية في هذه الحكومة، سواء من خلال أعضائها بشكل مباشر أو عبر أعضاء حكومة الإنقاذ، التي أسستها الهيئة في جيب صغير بشمال شرق سوريا عام 2017. وبلغت نسبة تمثيل الهيئة 39% من الوزراء، في حين ستكون حكومة الإنقاذ ممثلة بنسبة 26%، ما يرفع نسبة الحقائب الوزارية التابعة للهيئة نظريًا إلى 65%. وجاءت نسبة تمثيل التكنوقراط من خلفيات أكاديمية بـ35%.
تمثيل نسائي محدود جدًا
وكما كان متوقعًا، قوبلت التشكيلة الوزارية الجديدة بانتقادات واسعة في الأوساط السورية بسبب افتقارها للتنوع وضعف التمثيل النسائي. فقد حصلت سيدة واحدة فقط، وهي هند قبوات، على حقيبة وزارية لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وبلغت نسبة تمثيل النساء 4.35% مقابل 95.65% للذكور، ما يعكس تراجعًا واضحًا في حضور النساء السوريات في الحكومة، سواء على المستوى الوزاري أو في المؤسسات واللجان الرسمية.
واستبقت قبوات أدائها اليمين الدستورية أمام الشرع بكلمة قالت فيها إن وزارتها “تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعزز العدالة الاجتماعية التي افتقدناها لفترة طويلة”، مؤكدةً على العمل “بطريقة تشاركية كوزراء ومجتمع مدني معًا”. وأضافت مشددةً على ضرورة “تعزيز الثقة” وتحقيق التوافق بين الجميع لبناء “نظام اجتماعي عادل ومستدام يضمن التوزيع العادل للموارد”.
وبحسب السيرة الذاتية لوزيرة الشؤون الاجتماعية، فهي حاصلة على ماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة فليتشر، وكانت عضوًا زائرًا في جامعة هارفارد. تشغل حاليًا منصب مديرة قسم حوار الأديان في جامعة جورج ميسون، وعملت مستشارة بالبنك الدولي ورئيسة لمنظمة “تستقل”. كما شاركت في محادثات السلام السورية في جنيف، وحصلت على جوائز في مجال الدبلوماسية العامة.
تشير التشكيلة الوزارية الجديدة في سوريا إلى تحديات كبيرة تتعلق بتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، الأمر الذي يعكس ضعفًا واضحًا في التوازن الجندري. وهو ما جدد الجدل حول مدى التزام السلطات بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مشاركة أوسع للمرأة في عملية صنع القرار، خاصةً في مرحلة انتقالية تتطلب جهودًا متضافرة لبناء مؤسسات أكثر شمولًا وتمثيلًا للمجتمع بمختلف مكوناته.
وفي ظل هذا التمثيل النسائي المحدود جدًا، ترتفع أصوات الناشطات والحقوقيات محذرات من أن تغييب النساء عن المشهد السياسي يشكل انتكاسة خطيرة. فالتجارب الدولية تؤكد أن مشاركة المرأة في صنع القرار تعزز فرص تحقيق السلام المستدام والعدالة الانتقالية. ويثير ذلك تساؤلات حول قدرة الحكومة الحالية على تمثيل تطلعات جميع السوريين، وتحقيق إصلاحات حقيقية في مجتمع تشكل النساء فيه نصف عدد السكان.
“ليس رفاهية”
في سياق التحديات السياسية والاجتماعية، يثير ضعف التمثيل النسائي في الحكومة تساؤلات حول دور المرأة في صنع القرار. في ظل غياب التوازن الجندري، تتعالى الأصوات المطالبة بمشاركة أوسع، معتبرة أن تعزيز الحضور النسائي في المؤسسات يساهم في تحقيق العدالة والمساواة المجتمعية في ظل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
تصف الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والمديرة التنفيذية لمبادرة “دارة سلام”، رنا الشيخ علي، تمثيل النساء بسيدة واحدة في الحكومة الجديدة بأنه “محبط”، مؤكدة أن “النساء لا يقللنّ كفاءة أو معرفة، أو حتى من النواحي العلمية”. وترى أن هذه المرحلة الحساسة تحتاج إلى تواجد نسائي أكثر، إذ إن الدول التي خرجت من نزاعات وحروب “لم تستطع الوصول إلى الاستقرار والعدالة والسلام المستدام بسبب غياب المرأة على مستويي التفاوض والتمثيل السياسي”.
وتؤكد الشيخ علي أن الحديث عن التمثيل النسائي “ليس رفاهية”، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول “تلبية الأجسام المشكلة لاحتياجات المجتمعات”، خاصة أن نسبة النساء في المجتمع تبلغ 50%. وتشير إلى أن بعض اللجان التي شكلت حديثًا لم يكن فيها أي تمثيل نسائي، مثل اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، بالإضافة إلى مجلس الإفتاء الأعلى، حيث ترى أن غياب التمثيل النسائي “غير صحي”. وتستدرك في حديثها بالإشارة إلى أن هذه النقطة قد تكون موضع “خلاف”، نظرًا لوجود بعض المواضيع المرتبطة بـ”الشؤون الحياتية والأمور العقائدية”.
وتوضح الشيخ علي أن غياب التمثيل النسائي أو ضعفه يخالف مواد الإعلان الدستوري الذي يؤكد مراعاة سوريا للاتفاقيات الموقعة عليها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”، مشيرة إلى أن الاتفاقية تحدد نسبة تمثيل بـ30% في أي مجلس يُشكل. وتلفت الشيخ علي إلى أن الحقائب الوزارية التي كانت تُمنح للنساء لم تكن ذات أهمية مثل الحقائب السيادية، معتبرة أن سبب ذلك “مرتبط بالسياق”.
وتعيد الشيخ علي في نهاية حديثها ذلك إلى “خوف السلطة من الانتماءات الأيديولوجية”، وتضيف متسائلة إن كان غياب الأجسام أو الأحزاب السياسية أو حتى الفراغ السياسي “حالة صحية” أم أن الضغط يجب أن يكون في سياق تشكيل قوى سياسية تستطيع أن تعزز فكرة أن يكون الولاء للوطن فقط غير مرتبط بالأيديولوجيا والعقيدة.
تأثير سلبي على مسار العدالة الانتقالية
يتجلى ضعف التمثيل النسائي في المؤسسات الحكومية كسؤال جوهري حول دور المرأة في صنع القرار، حيثُ يبرز ضعف التمثيل النسائي في المؤسسات الحكومية كمؤشر على غياب هذا التوازن. وبينما تتزايد الدعوات لتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، تتجدد التساؤلات حول أثر الإقصاء على مسارات العدالة والتنمية.
ترى الطبيبة والروائية والناشطة السورية، نجاة عبد الصمد، في حديثها لـ”الترا سوريا”، أن كل ما هو “محدود أو محافظ أو مغلق، فإنه يغلق المجال أمام المكونات التي يجب أن تكون مشاركة فعليًا في أي مجال، وهو فكر إقصائي من حيث النتيجة”، لافتة إلى أن هذا الإغلاق “يعود بالخسارة على الطرفين، المُغلِق والمُغلَق عليه”. مؤكدةً أن هذا التوجه “يتعارض مع فكرة سوريا الحضارية التي تحفظ كرامة جميع مواطنيها وحقوقهم”.
وتتفق عبد الصمد مع الشيخ علي على أن نسبة النساء في المجتمع السوري تصل إلى 50%، وهو ما يجعلها تتساءل عن سبب “سياسة إقصاء النساء”، معتبرة أن “سياسة الإقصاء لا تعني أننا ما زلنا عند نقطة الصفر، وإنما قد نتراجع كثيرًا إلى الوراء”، مشددة على أنه “لا يمكن لأي إقصاء لأي مكون، وتحديدًا النساء، أن يصنع أي نقلة في سبيل تنمية أو تطوير سوريا، أو نقلها إلى مصاف الحضارة المعاصرة”.
وتؤكد عبد الصمد أن هذا الضعف في التمثيل النسائي سيكون له “تأثير شديد السلبية على مسار العدالة الانتقالية”، معتبرة أن ذلك يمثل إقصاءً لخبرات النساء التي اكتسبنها خلال السنوات الماضية. وتعلق ساخرة: “عادةً، يتقدم المجتمع إلى الأمام، وليس إلى الوراء”. كما تدين عبد الصمد ضعف التمثيل النسائي في الحكومة الجديدة، وترى أنه “إقصاء، وعدم اعتراف بالمؤهلات العالية”، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبًا بشكل كبير على “إعادة بناء الدولة والإيمان بحقوق الإنسان والمساواة”.
وتختتم عبد الصمد حديثها باقتباس من القاضية السابقة في المحكمة العليا الأميركية، روث غينسبورغ (1933 – 2020)، التي ردت على سؤال حول طموحها لعدد النساء في المحكمة بقولها: “أطمح أن يصل عدد تمثيل النساء في هذه المحكمة إلى تسعة من أصل تسعة”.
تكريس لواقع من التمييز غير المباشر ضد النساء
قوبل ضعف التمثيل النسائي في الحكومة السورية بانتقادات حادة. فغياب النساء عن مواقع صنع القرار لا يعكس فقط خللًا في التوازن الجندري، بل يشير إلى إقصاء منهجي للعدالة، نظرًا لإعادة هذه السياسات إنتاج أنماط الإقصاء التي تذكر بحقبة نظام الأسد المخلوع.
تعتبر الكاتبة والصحفية والرسامة يارا وهبي، في حديثها لـ”الترا سوريا”، أن “وجود امرأة واحدة فقط بين 23 وزيرًا لا يمكن اعتباره تمثيلًا، بل هو تكريس لواقع من التمييز غير المباشر ضد النساء في تولي المناصب السياسية، حتى في غياب تمييز صريح”. وتضيف أن “هذه النسبة الهزيلة ليست مجرد خلل عددي، بل تعكس نظرة ترى في النساء استثناءً لا قاعدة، وزينة رمزية تُضاف إلى الصورة الجماعية لإضفاء توازن شكلي”.
ومثل عبد الصمد والشيخ علي، تؤكد وهبي في نهاية حديثها أن “نساء سوريا هن نصف المجتمع”، مشيرةً إلى أن “أي حكومة تُقصيهن بهذه الطريقة إنما تُقصي العدالة معها”. وترى أن هذا النهج يعكس استمرارًا لـ”نفس العقلية الإقصائية التي يُفترض أنها سقطت مع النظام السابق”
الترا سوريا
——————————–
الحكومة الجديدة بين وعود التغيير ومخاوف التفرّد بالحكم
30 مارس 2025
تشكّلت الحكومة السورية الجديدة، التي يرأسها رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لتدير المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات، وسط مشاعر متباينة بين قبول متحفظ وانتقادات لاستمرار هيمنة “هيئة تحرير الشام”. وبينما رُوج للحكومة كمحاولة لتحقيق توازن سياسي، أثارت بعض التعيينات الجدل، بالإضافة إلى محدودية الصلاحيات المخاوف من استبعاد الأطراف السياسية وتعزيز الطابع الإسلامي للحكومة، وفقًا لعدة تقارير غربية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، ليل السبت – الأحد، عن الحكومة الجديدة التي ستتولى إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك عقب انتهاء مهلة حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير، التي كان من المفترض أن تنتهي في الأول من آذار/مارس الجاري. وتتألف الحكومة، التي يترأسها الرئيس، أحمد الشرع، بموجب الإعلان الدستوري، من 23 وزيرًا، بينهم 20 وزيرًا جديدًا.
“لا يمكنهم إدارة الأمور بأنفسهم”
تسلط صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الضوء في تقريرها على تفاعل السوريين مع الحكومة الجديدة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات، مشيرةً إلى مشاعر متباينة بين القبول المتحفظ لاستمرار هيمنة “هيئة تحرير الشام”، التي أطاحت بنظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
وبحسب “نيويورك تايمز”، تبدو الحكومة الجديدة بمثابة حل وسط مدروس، يجمع بين تلبية الدعوات لتشكيل مجلس وزاري أكثر تنوعًا يهدف إلى توحيد البلاد التي أنهكتها الحرب والانقسامات العميقة، مع الحفاظ على نفوذ حلفاء الشرع في الوزارات الأكثر قوة.
قال مدير السياسات في “إندبندنت ديبلومات”، لـ”نيويورك تايمز” قبيل مراسم أداء اليمين: “لا شك أن بعض الأصوات ستشعر بأنها لا تزال مستبعدة”. لكنه أضاف: “بشكل عام، هناك شعور بتفاؤل حذر حيال عملية الانتقال في سوريا، خاصة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة”.
من جهته، قال الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إبراهيم الأصيل، قبيل الإعلان عن الحكومة الجديدة أيضًا: “هناك حاجة لتوسيع الدائرة”، في إشارة إلى الدائرة الضيقة من حلفاء الشرع التي تولت إدارة الحكومة الانتقالية منذ كانون الأول/ديسمبر. وتابع مضيفًا: “من الضروري أن تكون الحكومة أكثر شمولًا، فمن جهة، يجب أن تعكس تنوع المجتمع السوري، ومن جهة أخرى، لأنهم بحاجة إلى دعم أوسع. لا يمكنهم إدارة الأمور بمفردهم”.
“نحتاج لأكثر من شخص في القيادة”
تُعيد صحيفة “واشنطن بوست” التذكير بأن بأن الإعلان الدستوري الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري أثار مزيدًا من المخاوف بشأن محدودية الدور التنفيذي للرئيس أحمد الشرع في قيادة المرحلة الانتقالية، رغم منحه صلاحيات شكلية مثل تعيين القضاة وأعضاء السلطة التشريعية، وإلغاء منصب رئيس الوزراء. ويرى مراقبون أن هذه الصلاحيات لا تعوّض افتقاره لأدوات النفوذ الفعلية في المشهد السياسي والعسكري المعقّد في سوريا.
وترى الزميلة البارزة في كلية لندن للاقتصاد، ريم تركماني، في تعليقها لـ”واشنطن بوست” على الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة، أننا “نحتاج إلى أكثر من شخص واحد في موقع القيادة”. وأضافت: “الإطار الذي حدده الدستور المؤقت أضعف بالفعل الحكومة القادمة”.
كما تضيف أن وجود امرأة واحدة فقط في التشكيلة الوزارية لا يعكس أن لدينا “حكومة شاملة”، واصفةً إلغاء منصب رئيس الوزراء بـ”الفرصة الضائعة”، لا سيما في ما يتعلق بالجهود المبذولة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
لكن الزميل البارز في المركز العربي للأبحاث في واشنطن، رضوان زيادة، يرى أن ضم أعضاء من العلويين والكرد والدرز والمسيحيين في سوريا، إلى جانب شخصيات سورية أخرى من خارج الدائرة السنية الإسلامية التي ينتمي إليها الشرع، قد يساعد في تهدئة المطالب الغربية بتوسيع التمثيل. وأضاف: “إنها حكومة شاملة، وتركز على التطلع إلى المستقبل بدلًا من التوقف عند صراعات الماضي”.
من جانبها، اعتبرت الكاتبة الصحفية، عليا منصور، أن هذه التشكيلة خطوة في مسار التغيير، وأضافت: “الأهم هو أن تبدأ عملية التغيير في سوريا، وأن تمضي المرحلة الانتقالية قدمًا”، بحسب ما نقلت “واشنطن بوست”.
تحديات الحكومة الجديدة
أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها إلى إعلان الشرع تشكيل الأمانة العامة للشؤون السياسية، التي منحت وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، صلاحيات واسعة في إدارة الوزارات، ما يشبه دور رئيس الوزراء، حيثُ يرى المحللون أن هذا التركيز للسلطة كان متوقعًا بسبب انعدام الثقة في مؤسسات خلال حكم آل الأسد، لكنهم يحذرون من استبعاد الفاعلين السياسيين الآخرين وتعزيز الطابع الإسلامي للحكومة.
منذ توليه السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، دعا أحمد الشرع السوريين في الخارج، الذين فروا من حكم الأسد، للعودة والمساهمة في إعادة بناء البلاد، التي تعاني من انهيار اقتصادي وفساد مستشري. لكن جهوده لم تحقق النجاح المنشود، إذ أعرب ثلاثة سوريين، التقوا بمسؤولين حكوميين عن ترددهم في العمل مع الدولة، خشية انزلاقها نحو الاستبداد وفرض مزيد من العقوبات، بحسب “فايننشال تايمز”.
وفقًا للمحلل السوري المقيم في لندن، مالك العبدة، فإن “الشرع بحاجة لكسب الوقت حتى تستقر الأمور ويتمكن من إقامة تحالفات قوية لحماية نفسه”. وأضاف أن الشرع عيّن في الحكومة أشخاصًا “مؤهلين نظريًا”، مشيرًا إلى أن ذلك “سيمنحهم بضعة أشهر إضافية من النوايا الحسنة”، وبعدها سيتضح ما إذا كان المعينون في الحكومة الجديدة يمتلكون سلطة فعلية.
كما تطرق مالك العبدة، في حديثه للصحيفة البريطانية، إلى تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا لسوريا، مشيرًا إلى أنه ناقد سابق ل”هيئة تحرير الشام” ولا يتبنى الفكر السلفي، الذي يُعد تيارًا سنّيًا متشددًا يعتنقه العديد من أنصار أحمد الشرع ومقاتليه.
وفيما أوضح أن غالبية الناس شعروا بالاطمئنان لتعيين الرفاعي، الذي شغل منصب المفتي العام للمعارضة السياسية في الخارج منذ أن ألغى الأسد هذا المنصب في عام 2021، فإنه أشار أيضًا إلى أن التعيين أثار استياءً بين بعض أتباع الشرع، مضيفًا: “المتطرفون من قاعدته الآن يقولون إنه من غير المقبول أن نقوم بثورة ويموت آلاف الأشخاص فقط لنجد أن السلطة الدينية باتت بيد شخص من مدرسة فكرية مختلفة”.
الترا سوريا
———————————–
ملفات ثقيلة أمام الحكومة الجديدة.. آمال السوريين ومطالب العالم/ سلمان عز الدين
30 مارس 2025
ولدت الحكومة الجديدة بعد مخاض طويل، وعندما تأخر الإعلان عنها ليلة أمس، 29 آذار/مارس، لنحو ساعة وربع، علق البعض بالقول: “هذه الحكومة لن تولد أبدًا”. غير أن قصر الشعب بدمشق قد شهد بالفعل، وأخيرًا، مؤتمر إعلان التشكيلة التي ضمت 23 وزيرًا، امرأة و22 رجلًا، اثنان منهما احتفظا بحقيبتيهما من الوزارة السابقة: أسعد الشيباني للخارجية، ومرهف أبو قصرة للدفاع.
وألقى الرئيس أحمد الشرع كلمة قال فيها إن سوريا تقف في لحظة فارقة “تتطلب منا التلاحم والوحدة”، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة “ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة”، مؤكدًا: “لن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا”. وألقى الوزراء كلمات مقتضبة، وأقسموا أمام الرئيس بأن يؤدوا مهامهم “بكل أمانة وإخلاص”.
ولم يتأخر السوريون في إعلان مواقفهم. كتب أحدهم أنه يكاد يطير “من السعادة.. هذا هو الحدث الأكثر أهمية منذ إسقاط بشار الأسد”، فيما كتب آخر: “الحكومة = الهيئة + حكومة الإنقاذ + تكنوقراط شوام سرعان ما سوف ينسحبون تباعًا”.
لكن آخرين كثر كانوا بعيدين عن وجهي هذا الاختزال، فعكفوا على تمحيص التشكيلة، ودققوا في أسماء الوزراء لمعرفة خلفياتهم المهنية والفكرية، ولاستنباط الدلالات والتوجهات العامة، مقدمين ملاحظات أكثر تركيبًا من الفرح الغامر والتشاؤم الشامل المعدين سلفًا.
ملامح عامة
يلاحظ الكاتب السياسي، سليمان الشمر، أن الحكومة الجديدة يغلب عليها طابع الـ”تكنوقراط”، وأن أغلب الوزراء خريجي جامعات أوربية. أما السمة الأبرز فهي أن “وزراء الحقائب السيادية الثلاث (الدفاع والخارجية والداخلية) كانوا مجددًا من الدائرة القريبة للرئيس، وهو الذي يولي موضوع الثقة الشخصية قيمة كبيرة، على حساب السياسة والساسة وخبراتهم”. ويقول الشمر: “هذا لم يكن مستغربًا قياسًا على نهج السلطة الجديدة، الذي مارسته منذ سقوط نظام الأسد، وهذا مطب أكثر منه ميزة، قد يعيق عمل الحكومة أو يقلل من نجاحاتها”.
يؤكد الكاتب والباحث السياسي، د. مأمون سيد عيسى، ملاحظة الشمر، فيقول: “من الواضح أن الرئيس الشرع، وكما هو متوقع، احتفظ بالوزارات السيادية ضمن الحلقة الضيقة التي يثق بها”، ويقترح تفسيرًا: “يبدو أن الضغوطات المتنوعة التي يتعرض لها، ومنها العقوبات وأحداث الساحل، دفعته للاحتفاظ بتلك الوزارات، إضافةً إلى اعتماده على تكنوقراط في أغلب الوزارات التي تحتاج سوية علمية وخبرة إدارية، مثل المالية والاقتصاد والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية”.
وبدوره، يتحدث الكاتب والأكاديمي، د. أحمد جاسم الحسين، عن سمات أساسية: “وزارة غلب عليها الشباب من مواليد الثمانينيات، كذلك هناك تنوع في الكفاءات، مع وجود عدد من الأسماء هي ممن اكتسب خبرات خارج سوريا وتعلموا ويحملون الشهادات العليا. وأيضًا جاءت الحكومة شاملة فضمت المسيحي والعلوي والكردي والدرزي والسني، كما شملت معظم المحافظات السورية”. ويضيف إلى ذلك أن الحكومة “امتازت أن كل وزير قدم خطة عمل أولية حاول من خلالها أن يبين استراتيجياته في إدارة الوزارة باختصار”.
ويضيء الحسين على أسماء محددة في الحكومة الجديدة “لديهم تجارب استثنائية كحالة رائد الصالح في الخوذ البيضاء، عبد السلام هيكل في الاتصالات والتقانة، وحمزة المصطفى في الإعلام ونجاحه في إدارة تلفزيون سوريا”. ويشير إلى اسمين من عهد النظام السابق: نضال الشعار المعروف بخبراته الدولية في البورصة وسوق المال العالمي، ويعرب بدر الذي عاد ليكون مجددًا وزيرًا للنقل.
ومن جهته، يرى مأمون سيد عيسى أن “رائد الصالح شخص مهم ورجل محترف في مجال عمله وسيرته عطرة، حمزة مصطفى لديه خبرة عملية جيدة في الإعلام من خلال القناة التي كان يديرها، ومحمد أبو الخير شكري جاء إلى وزارة الأوقاف، أغنى وزارة في الحكومة لما لديها في كل محافظة من عقارات، وهو شخصية محترمة يستطيع حل مشاكل الأوقاف المتراكمة شرط أن يعطى الصلاحيات المطلوبة، كما سيكون له دور في إبعاد أي خطاب متطرف عن الجوامع”.
ملفات ثقيلة
يعدد الباحث مأمون سيد عيسى الملفات ذات الأولوية التي تنتظر الحكومة الجديدة، فهناك “البنية التحتية العامة في سوريا، والتي تعاني من تدهور كبير نتيجة الإهمال الطويل بسبب الحرب. ويُعد إصلاح البنية التحتية للكهرباء والمياه على وجه السرعة أمرًا ملحًا، بالإضافة إلى ترميم الطرق والمطارات وتوفير النفط. كما أن البنية التحتية الصحية قد تعرضت للدمار التام”.
ويُنتظر من وزارة الخارجية “متابعة الإنجازات في الصعيد الخارجي. تعزيز العلاقات مع الدول والعمل على تخفيف العقوبات وتسريع تطبيق الاتفاق مع “قسد” وهو اتفاق تاريخي بامتياز سيساهم في استقرار وبناء الدولة السورية واستعادتها الموارد الكبيرة الموجود في المنطقة الشرقية”.
لكن سيد عيسى يرى أن التحديات التي تواجه الحكومة الحالية هي أكبر من أن يحلها وزراء في الحكومة الجديدة مهما كانت مؤهلاتهم “فلدينا العقوبات الدولية التي تعتبر التحدي الأكبر الذي يعيق جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار وعودة النازحين، ولدينا الدمار الاقتصادي الذي خلفته الحرب وانتشار الفقر بشكل كبير”.
ويتابع: “هناك حاجة ماسة لتقديم المساعدة العاجلة لأكثر من 6 ملايين نازح و2 مليون مقيم في المخيمات أو العائدين من شمال سوريا إلى مناطقهم، في مجالات المياه والغذاء والأدوية وإعمار بيوتهم، ولدينا 12 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية”، مذكرًا بأن “تكلفة الحرب في سوريا تقدر بأكثر من 500 مليار دولار”.
إضافة إلى تحدي البنية التحتية وإعادة الإعمار، هناك التحدي الأمني، ذلك أن مناطق عديدة لا تزال خارج سيطرة الدولة، والحالة الفصائلية لا تزال سائدة ما يجعل البلاد تعيش في ظل تهديد دائم وحالة أمنية هشة.
ويعتبر سليمان الشمر أن تحقيق الأمن والاستقرار هو أولوية “هذا هام ويلتقي مع مطالب الدول المعنية بالملف السوري”. ونظرًا للوضع المعقد الذي آلت إليه الحالة السورية بعد 14 عامًا من الحرب الدامية والمدمرة، فقد كان “يعول على تشكيلة الحكومة الجديدة أن تجعلها مؤهلة للتصدي لكل الملفات الثقيلة، كان هناك حاجة لأن يغلب عليها الساسة أكثر من التكنوقراط، فسوريا بحاجة إلى إدارة علاقات دؤوبة وفعالة لتأمين أكبر تعاون دولي للمساعدة في إعادة الإعمار والحفاظ على الاستقرار، إضافةً إلى عمل داخلي يعيد اللحمة الوطنية التي زادها الصراع تمزقًا، وكذلك الهموم المعيشية للفقراء الذين طحنتهم الحرب ويمثلون 90% من الشعب السوري”.
يعتقد أحمد جاسم الحسين أن نجاح الحكومة الجديدة في مهامها وفي الملفات التي تنتظرها منوط، أيضًا، باستجابة المجتمع الدولي والإقليمي، مرجحًا أن “ردود الأفعال دوليًا على تشكيلة الحكومة ستكون بين بين”، لكنه يرى أن “هذا حق سيادي، والمجتمع الدولي لن يرضى عنك مهما عملت، أثبت نفسك على أرضك وخذ القرارات التي تريح مواطنيك، وربما سيجدها المجتمع الدولي فرصة ليرضى عنك”.
يختم سليمان الشمر حديثه بالقول: “أما وقد تشكلت الحكومة الجديدة، فإننا كسوريين محكومون بالانتظار والترقب والأمل، عسى أن تجتاز بنا هذا الاختبار الصعب، وتنجح.. وننجح”.
الترا سوريا
—————————-
واشنطن تحدد شروطها لتخفيف العقوبات عن سوريا
الثلاثاء 2025/04/01
حددت الولايات المتحدة الأميركية شروطها للحكومة السورية الجديدة لإجراء تعديلات على العقوبات المفروضة على سوريا، معربةً عن أملها في أن يشكل إعلان تشكيل الحكومة، بداية تحول إيجابي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، بعد يومين على إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.
شروط واشنطن
وقالت بروس إن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من “الحكم الاستبدادي والقمع” في ظل نظام الأسد، معربة عن أملها في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري.
وأضافت أن أي تعديل جديد فيما يخص العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، سيكون مشروطاً بتنفيذ عدد الخطوات، هي نبذ السلطات السورية المؤقتة “الإرهاب بكافة أشكاله”، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي أدوار رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية.
كما طالبت المتحدثة باتخاذ خطوات عملية يمكن التحقق منها في تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع، إلى جانب المساهمة في الكشف عن مصير الأميركيين والمواطنين الآخرين المفقودين في سوريا، وضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية، وتأمين الحريات الأساسية لجميع المواطنين داخل الأراضي السورية.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة “ستواصل تقييم سلوك السلطة السورية المؤقتة وتحديد خطوتنا التالية بناءً على تلك الإجراءات”.
يأتي تعليق الخارجية الأميركية على خلفية إعلان تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، السبت الماضي، والتي تضمنت 23 وزيراً.
وقبل أسبوع، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي ناتاشا فرانشيسكي، سلمت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قائمة من الشروط من أجل تخفيف العقوبات، وذلك في اجتماع على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل.
ترحيب أوروبي
من جانبه، رحّب الاتحاد الأوروبي بتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وعدد من المفوضين الأوروبيين، إن “الاتحاد الأوروبي مستعدّ للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها”، حسب وكالة “فرانس برس”.
كما لاقى تشكيل الحكومة الجديدة ترحيباً من قبل دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب العديد من الدول العربية، حيث أكدوا استعدادهم للتعاون معها.
——————————
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
1/4/2025
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداء
حدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
ويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته “تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع”.
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دولية
ويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
ويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاص
أوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافي
وأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي.
جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة.
دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي.
تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري.
رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.
ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه “لمشروع مارشال”، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
المصدر : الجزيرة
————————–
وزيرة وحيدة في حكومة سوريا الجديدة.. من هي هند قبوات؟
الحرة – واشنطن
30 مارس 2025
تضمنت تشكيلة الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها، السبت، وزيرة وحيدة، حيث تولت هند قبوات حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وخلال كلمتها على هامش الإعلان عن الحكومة الجديدة، قالت قبوات إن وزارتها “تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعزز العدالة الاجتماعية التي افتقدناها لفترة طويلة.”
وأضافت: “سنعمل بطريقة تشاركية كوزراء ومجتمع مدني معاً، ويجب تعزيز الثقة بيننا جميعاً. يجب أن يكون هدفنا جميعاً نظام اجتماعي عادل ومستدام، يضمن التوزيع العادل للموارد.”
وكانت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع اختارت قبوات لعضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، التي أعلن عنها في فبراير الماضي.
كلمة السيدة هند قبوات عضو اللجنة التحضيرية في الفعاليات الختامية لمؤتمر الحوار الوطني السوري#مؤتمر_الحوار_الوطني_السوري#سانا pic.twitter.com/tjMh4M5gmE
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 25, 2025
وقبوات حاصلة على ليسانس في الاقتصاد والقانون من جامعة دمشق، وعلى شهادة حل النزاعات والتحكيم من جامعة تورنتو في كندا، حسب السيرة الذاتية التي نشرتها الرئاسة السورية.
السيرة الذاتية للسيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية في التشكيلة الحكومية السورية الجديدة.#سانا pic.twitter.com/s0W3Psmp0J
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 29, 2025
وهي حاصلة كذلك على ماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة فليتشر في الولايات المتحدة، وأستاذة في جامعة جورج ماسون الأميركية.
وشغلت قبوات منصب عضو زائر سابقا في برنامج التفاوض بكلية القانون في جامعة هارفرد، كما ساهمت في العديد من المؤسسات والمنظمات المدنية الفاعلة في سوريا وخارجها.
وقبوات، هي سورية كندية قادت العديد من الجهود في مجال الدبلوماسية العامة في السنوات الأخيرة في سوريا للترويج للتسامح والتعاون بين الأديان، والتحديث والإصلاح بالإضافة إلى الابتكارات التعليمية في مجال حل النزاعات والتعليم الدبلوماسي.
وتدير قبوات، وهي مسيحية، قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية في جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا الأميركية، وهي أيضا مؤسسة ومديرة لمركز الحوار والسلام والمصالحة السوري في تورونتو.
وعملت كمستشارة وعضو في المجلس الاستشاري للبنك الدولي، وهي تشغل أيضا رئاسة منظمة “تستقل” المعنية بشؤون المرأة وبناء السلام.
@G_CSyria
بالإضافة لذلك ترأس قبوات “جمعية النساء السوريات الكنديات” في تورونتو، إلى جانب عضويتها في مجلس إدارة منظمة “إنتربيس” المستقلة المعنية ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺴﻼم ومقرها جنيف.
وهي عضوة أيضا في مجلس المنتدى الاقتصادي السوري ومنظمة المسيحيين السوريين من أجل السلام.
وكانت قبوات نائبة رئيس مكتب لجنة المفاوضات السورية في جنيف وعضوة سابقة في اللجنة العليا للمفاوضات وشاركت في جميع الجولات الثماني لمحادثات السلام في جنيف بشأن سوريا.
حصلت قبوات على جائزة من مركز “Tanenbaum” لصانعي السلام في العمل وجائزة أخرى من جامعة جورج ميسون في مجال الدبلوماسية العامة.
وأعلن الشرع، السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث احتفظ كل من مرهف أبو قصرة بمنصب وزير الدفاع وأسعد الشيباني بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.
الحرة – واشنطن
—————————-
الشيخ الحناوي يبارك تشكيل الحكومة السورية الجديدة ويشيد ببرامج الوزراء
2025.04.01
رحّب شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حمود الحناوي، بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مشيداً بطريقة تقديم الوزراء لخططهم وبرامجهم في إدارة الوزارات.
وقال الشيخ الحناوي في مقطع مصور: “كنت، كسائر أبناء الشعب السوري، أنتظر إعلان الحكومة الجديدة، وقد أعجبني الأسلوب الذي جرى فيه الإعلان، حيث عمل الرئيس أحمد الشرع على إشراك العديد من أهل الرأي والمشورة في أثناء عرض التشكيلة الوزارية”.
وأثنى الحناوي على أداء الوزراء خلال مراسم الإعلان، مشيراً إلى أن كل وزير قدّم برنامجه بشكل موجز وشامل، وأضاف: “البلاغة في الإيجاز، وقد لاحظنا وضع عناوين مدروسة لكل خطة، وهذا يُعدّ أمراً إيجابياً”.
وتابع: “وقد اختُتم الإعلان بأداء الوزراء للقَسم، متعهدين بتحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص، وإذا تحققت الأمانة والإخلاص، فالنجاح حتمي بإذن الله”.
وختم الشيخ الحناوي تصريحه بالتأكيد على أن “غايتنا في كل ما نقوم به هي التوفيق والعمل لصالح الوطن”.
الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة
ومساء السبت، جرى في قصر الشعب بالعاصمة دمشق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيراً، بينهم سيدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
ترحيب عربي ودولي واسع بالحكومة السورية الجديدة
وقوبل إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة بترحيب واسع على المستويين العربي والدولي، حيث أعربت عدة دول ومنظمات عن دعمها للتشكيلة الجديدة، مؤكدة أهمية الاستجابة لتطلعات الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات التي أبدت دعمها، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس حرص المجتمع الدولي على دعم جهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.
تلفزيون سوريا
—————————
السويداء.. فصيل محلي يربط الاندماج بنجاح الحكومة
تحديث 01 نيسان 2025
ربط قائد “لواء الجبل”، العامل في السويداء جنوبي سوريا، شكيب عزام، قرار انضمامه للجيش السوري الجديد بنجاح الحكومة الانتقالية الجديدة.
وقال قائد “لواء الجبل” عزام، إن الفصائل ذات الطابع الدرزي، أرادت منح الحكومة المؤقتة فرصة لإثبات جدارتها، مهددًا بقتالها في حال الفشل.
وأضاف في مقابلة لصحيفة “نيويورك تايمز” ونشرت اليوم، 1 من نيسان، “إذا سارت الحكومة الجديدة على الطريق الصحيح، فسننضم إليهم، وإن لم ينجحوا، فسنقاتلهم”.
ويرى عزام أن فصيله سيكون جزءًا من الدولة الجديدة، مشترطًا أن يكون لهم رأي في القرارات السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن “من السابق لأوانه التخلي عن السلاح”.
ويأتي حديث عزام، بعد أيام من تشكيل حكومة جديدة انتقالية، وصفت بأنها شاملة للطوائف السورية، وضمت وزيرًا من محافظة السويداء.
ما “لواء الجبل”؟
“لواء الجبل” أسسه مرهج الجرماني، وهو فصيل درزي مسلح يتمركز في السويداء.
شارك الجرماني في الاحتجاجات التي قامت ضد النظام السوري السابق، في السويداء والتي اندلعت عام 2023، وتم اغتياله عام في تموز 2024.
ويعتبر “لواء الجبل” من أكبر الفصائل العاملة في السويداء ويشكل مع فصيل “حركة رجال الكرامة” تحالفًا يرسم الوجه العسكري البارز في المحافظة.
وقال الفصيلان في بيان مشترك، الاثنين 6 من كانون الثاني الماضي، إن “حمل السلاح كان دفاعًا عن أهل السويداء بجميع أطيافهم وليس حبًا به، وهو وسيلة اضطرارية وليس غاية”.
وأكد الفصيلان استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري، ورفضهما لأي جيش فئوي أو طائفي، معتبرين نهاية حكم نظم الأسد “فرصة تاريخية لبناء دولة عادلة”.
وتضمن البيان موقفًا بعدم تدخل الفصائل العسكرية في الشؤون الإدارية أو السياسية، مع دعم العمل المدني والسياسي بشكل تشاركي، والتزامهما بحماية المرافق العامة في المحافظة.
دمشق تفاوض فصائل السويداء
ولا تزال فصائل عسكرية يتكون معظمها من الدروز تسيطر على المشهد العسكري والأمني في السويداء، دون أن ينضموا إلى وزارة الدفاع السورية.
وتجري مفاوضات، بين فصائل السويداء ووزارة الدفاع السورية، تراجعت وتيرتها عقب أحداث الساحل السوري التي اندلعت في 6 من آذار الماضي، عقب تحركات لفلول النظام السابق.
أدت أحداث الساحل إلى انتهاكات في صفوف المدنيين، مما أثار تخوفات لدى فصائل السويداء، وجعلها تحجم عن مواصلة التفاوضات مع الدولة السورية، وفق “نيويورك تايمز”.
من جانبه، قال فهد البلعوس نجل مؤسس “رجال الكرامة” وحيد البلعوس، لعنب بلدي في وقت سابق، إنه بعد عدة اجتماعات تذللت معظم العقبات في مسألة الخلاف حول الانضمام لوزارة الدفاع.
ولفت إلى ضرورة حل جميع الفصائل من أجل بناء الدولة والابتعاد عن التبعية الفصائلية أو الطائفية لتفادي ما وصفها بـ”الحرب الأهلية”.
وعقد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عدة اجتماعات مع ممثلين عن الطائفة الدرزية كان أبرزها في شباط الماضي، وحضره البلعوس.
وحول الشروط التي دارت حولها الاجتماعات قال البلعوس، إن أهمها كان الخدمة العسكرية لشباب المحافظة ضمن الحدود الإدارية للسويداء حتى يحين صياغة دستور يضمن حقوق جميع السوريين.
وبالرغم من عدم انضمامها، فإن تفاهمات جرت بين الفصائل ودمشق، على تنسيق خدمي وأمني.
تمثلت هذه التفاهمات بإعادة تفعيل مراكز شرطية وتعيين مسؤولين عليها من محافظة السويداء، ودفع رواتب عناصر شرطة سابقين ومنشقين عن النظام السابق.
——————————–
الإدارة الذاتية الكردية تعلن رفضها تنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا
الإدارة الذاتية الكردية: “أية حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها”
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان الأحد أنها لن تكون “معنية” بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا غداة الإعلان عن تشكيلها، على اعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة التي تضمّ وزيرا كرديا واحدا من بين 23 وزيرا “تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها”، مضيفة أن “أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم (…) ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها”.
وشددت على أن “السياسات التي تصر حكومة دمشق على انتهاجها، إنما تعيدنا إلى المربع الأول، من حيث استئثار طرف واحد بالحكم وإقصاء المكونات والأطياف السورية من العملية السياسية ومن إدارة شؤون البلاد”.
وأكدت أن “أية حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها”.
وأعلنت أنهم “لن يكونوا معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها”، لافتة إلى أن “تكرار أخطاء الماضي سيضر السوريين ولن يؤدي أبدا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة يمكن أن تضع الحلول للقضايا العالقة والمشاكل والأزمات التي تعيشها سوريا”.
وجددت الإدارة الذاتية تمسكها بـ “المطالب الأساسية في بناء سوريا ديموقراطية تشاركية لا مركزية تضمن للجميع حق المواطنة وحق المشاركة العادلة في جميع مفاصل الحياة السياسية، وعدم تحكم جهة أو طرف واحد بمقاليد الحكم وإدارة سوريا”.
وطالبت بـ”الكف عن انتهاج سياسات الإقصاء والتهميش والاتجاه إلى احتضان جميع أبناء الشعب السوري من كل المكونات والأديان والطوائف”.
النهار العربي
————————-
===================