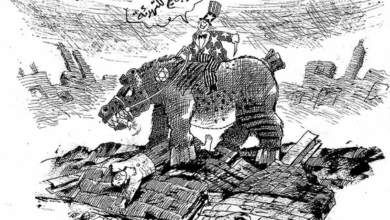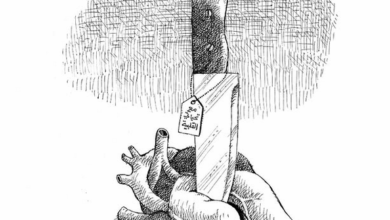الإعلان الدستوري لسوريا 2025-مقالات وتحليلات- تحديث 02 نيسان 2025

لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
———————————-
الدين والهويّة في الدساتير السورية… الإعلان الدستوري وحقوق الأقليات/ شفان إبراهيم
02 ابريل 2025
شكّل الدستور السوري، وعلى مدى تاريخ البلاد الحديث، أبرز معالم الخلافات وطبيعة الصراعات السياسية والاجتماعية، وإيقاع العلاقة بين المكوّنات والدولة، وتنوّعت محاولات السيطرة لترسيخ حكم ديمقراطي أو استبدادي، على حدّ سواء، وغالباً ما كان المواطن السوري في الحدّ الأدنى لسلّم الأولويات، في مقابل تعزيز السلطة المطلقة والهيمنة الحزبية. وعلى اعتبار أن الدساتير تأتي لاستيعاب التغيّرات السياسية والاجتماعية التي تطرأ على البلاد من حروب أو كوارث أو تغيير في بنية الأنظمة السياسية، فإنّ المطلوب أن تكون موادّ الدستور معبّرةً عن تطلّعات وآمال المكوّنات والقوميات، وضامناً لمسارات السلام والعيش المشترك والاستقرار، من دون تمييز أو إقصاء.
حالياً، تشكّل المواد الدستورية المتعلّقة بحقوق القوميات والأقلّيات، في دساتير الدولة السورية منذ تأسيسها، نقاطاً خلافيةً بشأن هويّة الدولة وشكلها واسمها وديانة رئيسها.
العثمانيون والحكم الملكي… والانتداب الفرنسي
انسحب العثمانيون من سورية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1918، مع تشكيل حكومة وطنية، وفي مايو/ أيار 1919، ووفقاً لمقترح الأمير فيصل، جرت انتخاباتٌ لأعضاء المؤتمر السوري العام، عبر ناخبين ثانويين انتخبوا نواب مجلس المبعوثان العثماني في إسطنبول عن ولايتَي دمشق وحلب، في حين أُكتفي في باقي مناطق بلاد الشام باستلام عرائض وقّعها الأهالي لاختيار الممثلين. وفي 8 مارس/ آذار 1920 أُعلن عن استقلال سورية وقيام المملكة السورية العربية، ولم يحظ الكيان بأي اعتراف دولي، وأهم ما جاء في دستورها أن سورية “مَلَكية مدنية نيابيّة، عاصمتها دمشق ودين ملكها الإسلام”، وكفل الدستور المساواة بين جميع السوريين، وبيّنت المادة 47 من الفصل الخامس أن المؤتمر العام يتكون من غرفتَين، مجلس النواب المنتخب من الشعب على درجتين، ومجلس الشيوخ المنتخب من مجلس النواب بمعدل ربع عدد أعضاء نواب المقاطعة الواحدة في مجلس النواب، ويعيّن الملك نصف العدد المنتخب عن كل مقاطعة أيضاً، والمادة 88 من الفصل الخامس تقول إن كلّ مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة للأقلّيات. اللافت في دستور تلك الفترة اعتماد إدارة البلاد على قاعدة اللامركزية، إذ جاء في الفصل 11: المواد “123- 124- 125” أن المقاطعات تدار بطريقة اللامركزية في إدارتها الداخلية، وتشكيل مجلس نيابي وحكومة خاصّة لكل مقاطعة، ويعيين الملك حاكماً عليها، وتترك إدارة شؤونها الداخلية لمجلسها، أما الأمور الخاصّة بالمملكة فمن شؤون المركز.
طبّق هذا الدستور 15 يوماً فحسب، ولم تطبق أغلب بنوده بسبب تلاحق الأحداث التي بلغت ذروتها مع إنذار الجنرال غورو وسيطرة الفرنسين على دمشق في 25 يوليو/ تموز 1920 وفق معاهدة سان ريمو وقرار عصبة الأمم.
أعلن الانتداب الفرنسي تعطيل العمل بالدستور، وتقسيم البلاد في 1 سبتمبر/ أيلول عام 1920 إلى دولة اتحادية على أسس مذهبية ومناطقية، وفي 1 يناير/ كانون الثاني عام 1925، حُلّ الاتحاد وأعلنت الوحدة بين دولتي دمشق وحلب فحسب، وأصدر المفوض الفرنسي الجديد ماكسيم فيغان قراراً آخر اعتُبر بمثابة القانون الأساس للدولة، نصّ على أن عاصمة الدولة دمشق ولحلب الامتياز الإداري والمالي، مع استمرار فصل السويداء واللاذقية، وأطلق على عملية الوحدة تلك “الدولة السورية”. طالبت الثورة السورية الكبرى التي انطلقت من السويداء، في 21 يوليو/ تموز 1925، بوحدة البلاد السورية وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، وانتُخبت جمعية تأسيسية لتحقيق الوحدة السورية. ومن سياق القرارات السابقة، كان واضحاً أن النظام الاتحادي هو الساري المفعول، حتى بعد توحيد دولتَي حلب ودمشق، إذ جرى تقاسم السلطات والصلاحيات والثروات بينهما، ولم ترد على الإطلاق أيّ إشارات أو عبارات إلى عروبة الدولة.
دساتير 1928 و1930 و1950
شُكّلت لجنة دستورية لإعداد دستور جديد عُرف باسم دستور 1928، ومن أبرز ما جاء فيه أن سورية جمهورية نيابية عاصمتها دمشق ودين رئيسها الإسلام، ونصّ على تمثيل الأقلّيات الدينية والعرقية على نحوٍ عادل في البرلمان وسائر مؤسّسات الدولة. شكّل هذا الدستور بدايةً مبشّرةً لاسم الدولة وحقوق المكوّنات والحرّيات والمساواة، وبلغ عدد أعضاء المجلس النيابي 60 عضواً عام 1932 ثم رُفع العدد إلى 90 بعد انضمام دولتَي الدروز وجبل العلويين إلى سورية عام 1936، ورُفع العدد مجدّداً إلى 124 عام 1943، وأخيراً رُفع إلى 140 عضواً في انتخابات العام 1947، وهي آخر انتخابات تجري في ظلّ هذا الدستور.
وجاء في الباب الأول لدستور 1930، الفصل الأول، المادة الأولى، أن سورية دولة مستقلة ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أيّ جزء كان من أراضيها، وقالت المادة الثالثة إنّ سورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام، وعاصمتها مدينة دمشق، وفي المادة 24: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع دوائر الدولة إلّا في الأحوال التي تضاف إليها بهذه الصفات لغات أخرى بموجب القانون أو بموجب اتفاق دولي، وفي المادة 28: حقوق الطوائف الدينية المختلفة مكفولة، ويحق لها إنشاء المدارس لتعليم الأحداث بلغتهم الخاصة، وفي الباب الخامس، المادة 113: تقوم بشؤون العشائر البدوية إدارة خاصة تحدّد وظائفها في قانون تراعي حالته الخصوصية.
والملاحظ هنا أنّ الإدارة الفرنسية شكّلت دولةً خاصّة لكلٍّ من الدروز والعلويين والحلبيين والشاميين، ولسكّان أنطاكية وإسكندرون حكماً ذاتياً. في حين شكّلت لواء الجزيرة بعد فصل قضائَي القامشلي والحسكة عن لواء الفرات (دير الزور)، وألحقت بلواء الجزيرة الأراضي التي ألحقت بالدولة السورية بين حدود قضاء القامشلي ونهر دجلة، وهي نواحي: الشدّادي وسري كانيه، وقرمانة (قرية تتبع الدرباسية حالياً)، وبويرات، وقضاء دجلة، وناحيتَي مصطفاوية وديرون آغا. وخلال تلك الفترة نجحت النخب العربية السُّنية بالسيطرة على مقدّرات دولة سورية، التي تشكّلت من دمج دويلات حلب ودمشق والعلويين، بالتزامن مع رغبتهم في السيطرة على لواء الجزيرة، حيث معقل الأكراد، وبعد الفشل في التأثير عبر المدّ القومي، لجأت تلك النخب إلى استغلال الرابطة الدينية، عبر ما يُعرف في العلوم السياسية بـ”الزبائنية”، لتبادل المصالح بين المركز والأتباع في الأطراف، مع ذلك عُيّنت الغالبية العظمى في الوظائف الإدارية والمهمة من خارج المحافظة، ولم تنل اللغة والخصوصية القومية للشعب الكردي أيَّ اعتراف من تلك النُخب، ما دفع مجموعةً من وجهاء العشائر الكردية والمسيحية إلى تقديم عريضتَين للانتداب الفرنسي مسجَّلتَين في ديوان المفوّض السامي الفرنسي، الأولى عام 1930، والثانية في 1933، تحت رقم “6501”، طالبت بمعاملة الأكراد معاملةً مماثلةً لبقيّة المكوّنات السكّانية الخاضعة للانتداب الفرنسي، وبأنهم يستحقون إدارةً خاصّة تماماً، وبقبول الكرد في الوظائف العامة والإدارة والعدالة والجندرمة والشرطة، وبقبول اللغة الكردية لغةً رسميةً في الدوائر العامة، وتأسيس مدرسة كردية في الحسكة لتأهيل المعلمين من مختلف أجزاء كوردستان.
أُقرّ دستور 1950 بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي، وأتى نتيجة لنقاشات مستفيضة ضمن جمعية تأسيسية منتخبة، ومن بين موادّه، الفصل الأول: في الجمهورية السورية، المادة الأولى: سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة، والمادة الثالثة: دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، والمادة الرابعة: اللغة الرسمية هي اللغة العربية، كما أن كلّ الدساتير التي كُتبت بعده جاءت نتيجة انقلابات عسكرية، وقد جرى تعليقه بعد الانقلاب الثاني لأديب الشيشكلي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1951 على هاشم الأتاسي. وشكلّ الدستور انتكاسةً جديدةً على صعيد التعددية السياسية والإثنية، بالرغم من إنه قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية، وسحب حقّ نقض القوانين والمراسيم منه، وأمهله عشرة أيام فحسب، وسُمي بدستور الاستقلال.
وفي عام 1946، جلت فرنسا عن سورية بعد أن رسمت معالمها الجديدة، واتخذت حكومة الجلاء من دستور عام 1928 دستوراً للبلاد وحكمت بموجبه، وكان ينصّ على أن “سورية جمهورية نيابية، دين رئيسها الإسلام، وعاصمتها مدينة دمشق”. وفي 1947 عُدّل الدستور بتحويل النظام الانتخابي من درجتَين إلى درجة واحدة، وعدّل مرّة ثانية عام 1948 للسماح بانتخاب شكري القوتلي لولاية ثانية مباشرة بعد ولايته الأولى، وفي 30 مارس/ آذار 1949 انقلب حسني الزعيم عسكرياً على الحكم المدني برئاسة القوتلي، وعلّق العمل بالدستور، وسرعان ما انقلب عليه سامي الحناوي في أغسطس/ آب 1949، ونُظّمت انتخابات جمعية تأسيسيّة (شاركت فيها المرأة للمرّة الأولى) لوضع دستور جديد للبلاد.
الوحدة مع مصر وما بعدها
جُمّد العمل بالدستور السابق، وصدر دستور مؤقّت بين عامي 1958-1961، وتحوّلت سورية جزءاً من الجمهورية العربية المتحدة، ومثّلت الوحدة تجسيداً واقعياً لرؤية حزب البعث في مجتمع عربي اشتراكي موحّد، وكانت ذات نظام مركزي مؤلّف من إقليمَين شماليّ في سورية، وجنوبي في مصر، وحُلّت الأحزاب السياسية جميعها في سورية بما فيها “البعث”، وجاءت المادة الأولى من الدستور مؤكدةً على القومية العربية وحدها من خلال تسمية الجمهورية العربية المتحدة (جمهورية ديمقراطية) تعدّ جزءاً من الأمة العربية، أمّا المادّة الثانية فقد منحت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمواطني كلٍّ من مصر وسورية، لكنّها استمرّت بالتغافل عن الكرد المجرّدين من الجنسية والهويّة السورية.
وبعد الإعلان عن انقلاب ضدّ الجمهورية العربية المتحدة، عاد العمل بدستور 1950، وأُعيدت تسمية البلاد بـ”الجمهورية العربية السورية”، وبقي معمولاً به حتى انقلاب 8 مارس (1963)، وبعد ذلك صدر دستورا 1964 و1969 المؤقتان بُعيد استلام حزب البعث السلطة، ركّزت موادهما أساساً على أن “القطر السوري جمهورية ديمقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة وهو جزء من الوطن العربي”، إضافة إلى سيادة الحزب الواحد والمفاهيم الاشتراكية، ثم أُصدر الدستور المؤقّت للجمهورية العربية السورية 1971 بعد ما عُرِف بـ”الحركة التصحيحية”.
كان الدستور ما بين عام 1973 و2012 أسوأ الدساتير السورية، وأطولها عمراً. اعتبر أن سورية جزء من “اتحاد الجمهوريات العربية” و”الشعب في القطر السوري جزء من الأمة العربية”، وحصر الرئاسة في “البعث”، في استبعاد لباقي مكونات الشعب، واعتبر “البعث” قائداً للدولة والمجتمع، وفقاً للمادة “8”، ونصّ على أن دين الرئيس هو الإسلام، والفقه المصدر الرئيسي للتشريع. في يوليو/ تمّوز 2000 خفص تعديل الدستور عمر مرشح الرئاسة من 40 عاماً إلى 34 عاماً، لتمكين بشّار الأسد من الترشّح للمنصب خلفاً لوالده.
شكلياً، جرى تعديل بعض مواد دستور عام 1973، لكنّها حافظت على المضمون الأساسيّ الذي تسبّب بالإشكاليات المجتمعية، بالرفض من جانب القوميات والأديان الأخرى، فأعيد التأكيد أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، والفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، واسم الجمهورية العربية السورية للدولة، والهويّة العربية للشعب، واللغة الرسمية هي العربية، وجرى تبديل المادة الثامنة من احتكار “البعث” للسلطة إلى التعدّدية السياسية، فورد فيها “يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتجري ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع”، وأُلغيت حالة الطوارئ، لكن سياسة الاعتقالات والخطف لم تنتهِ إلى يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، لحظة سقوط الطاغية.
الإعلان الدستوري 2025
شكّل الإعلان الدستوري المعلن في مارس/ آذار 2025 صدمة كبيرة، خاصّة للأطراف السياسية والحزبية، والقوميات والأقلّيات الدينية مثل الكرد والآشوريين والدروز وأطراف سياسية عربية عديدة، وشكّل قسم من مواده مخاوف جوهرية تعرقل الانتقال الديمقراطي، خاصّة صلاحيات رئيس الجمهورية، وغياب آليات رقابية فاعلة، وأن كلّ ما كُتب بُني على أساس نتائج مؤتمرَي الحوار والنصر وهما لا يعكسان تمثيلاً حقيقياً للسوريين كلّهم، وغياب ضمانات الرقابة أو المساءلة والمحاسبة، والمواد المتعلقة باسم وهويّة الجمهورية السورية والإصرار على عروبتها، وتحديد دين رئيس الدولة بالإسلام، واعتبار الفقه الإسلامي مصدرَ التشريع، واللغة العربية هي الرسمية، وإطالة مدّة المرحلة الانتقالية لتبلغ خمس سنوات، كما وردت بعض المواد والجوانب الإيجابية التي يُمكن البناء عليها، مثل تقييد السلطة التنفيذية عبر عدم منح الرئيس الانتقالي سلطة إصدار المراسيم التشريعية أو العفو العام أو رئاسة مجلس القضاء الأعلى، كما نصّ الإعلان على جعل جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الجمهورية السورية، جزءاً لا يتجزّأ من هذا الإعلان الدستوري، وتحديد مدة الطوارئ بثلاثة أشهر حداً أقصى، وإحداث هيئة للعدالة الانتقالية، ما سيكون إطاراً نظرياً لمساءلة عادلة.
خاتمة
لا تتناسب الدولة الوطنية المطلوبة اليوم لسورية والإعلان الدستوري الحالي؛ إذ لا يُمكن استمرار عقلية الإقصاء، رغم أن الدساتير القديمة أنصفت المكوّنات والقوميات في مرّات كثيرة، ومنحتهم حرّية التعبير والهويّة والانتماء والخصوصيات.
من جهة أخرى، لم يتمتع الكرد في تاريخهم الحديث بأيّ استقرار أو حقوق مواطنة، وعلى الرغم من كمية التضحيات والعمل لبناء الدولة السورية، التي أُلحقوا بها من دون استشارتهم، ولا حتّى استشارة العرب والآشوريين، بل المكوّنات كلّها، فارتضوا العيش معاً، لكن تعاقب الأنظمة السياسية على حكم سورية لم يشفع لهم. ومنذ انهيار السلطة العثمانية وحقبة الفرنسيين والحكم الوطني وفترة الانقلابات وعهد الوحدة، ثمّ حزب البعث، وعبر اللجنة الدستورية خلال مفاوضات جنيف حول سورية، تأرجحت الحياة السياسية دستورياً ما بين التعريب أو التعددية السياسية، لكن لم يُمنح الكرد الاعتراف الذي يستحقونه.
ولا يعدّ العناد أمام الرغبة الشعبية دهاءً سياسياً، بل اجترارٌ لأخطاء الأنظمة الماضية، فالأفضل التراجع قليلاً وإصدار مُلحق أو تتمة، أو الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل لانتخاب جمعية تأسيسية تشمل جميع المكونات للبتّ في اسم الجمهورية وهويّتها والعلاقة بين الدين والدولة، ومخرجات مؤتمر النصر والحوار الوطني، يُمكن أن تُتمَّم بخطوات إضافية لسدّ النواقص، وبالتالي يكون المؤتمر التأسيسي/ الجمعية التأسيسية ممثلة لجميع القوى الديمقراطية والسياسية والاجتماعية.
ينبغي إرساء أسس دولة مدنية تقوم على المواطنة وفصل السلطات، وتضمين مواد تؤكّد عدالة التقسيمات الإدارية بالنسبة للسكّان والمساحة والموقع الجغرافي، ويكون لها تأثير في نسبة المشاركين في الترشيح والانتخابات وعدد المقاعد في البرلمان السوري. وليتساوى الجميع أمام القانون وفي المواطنة، يستلزم أن تكون الدولة حيادية لا تفضّل ديناً على آخر، ولا تمنح الأولوية لقومية على أخرى، وهو ما يتطلّبه بناء هويّة سورية جامعة.
وينبغي توزيع الصلاحيات وتفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة والمساءلة المجتمعية، واحترام الشريعة الإسلامية، وأن تكون أحد مصادر التشريع، أما الديمقراطية، فليست وحشاً كاسراً، بل إنّها مبدأ عمليٌ ومرجع مهم في حماية سورية من الانسلاخات الجغرافية، فالتعدد القومي والديني والطائفي حقيقة واقعية ووجودية، وسورية لم تكن في يوم من الأيام مكوّنةً من لون واحد، بل دوماً شكّل الكرد والآشوريون والسريان والدروز والعلويون والمسلمون، السُّنة والشيعة، أركان هذه البلاد.
واللغة الكردية تاريخية من حيث الأدب ولغة التدوين والتاريخ، واعتبارها لغةً رسمية في مناطق الكرد أولوية وضرورة ملحّة، لا تقل عن أيّ حقّ آخر، ويجب اعتبارها لغةً ثانية في الجامعات والمعاهد.
ضحّى السوريون والسوريات بالكثير من أجل لحظة الانعتاق والخلاص والعيش في كنف العدالة والمساواة والديمقراطية والتعددية وحرية المعتقد؛ لهذا يستحقّ السوريون فرصةَ إعادة بناء بلادهم ضمن فضاء ديمقراطي غير أحادي الجانب.
العربي الجديد
——————————–
المخاض السوري… ضرورة التنازلات المتبادلة والتوافق/ علي العبدالله
02 ابريل 2025
اكتملت المائة يوم الأولى على تسلّم الإدارة الجديدة السلطة في سورية، الفترة المعيارية المعتمدة في مناهج البحث السياسي لقياس مدى نجاح السلطة الحاكمة في إدارة البلاد، وتنفيذ برامج وخطط عمل تستجيب لمصالح المواطنين وتطلّعاتهم، واعتبار ذلك مؤشّراً على نجاحها في المتبقّي من فترة ولايتها… مرّت من دون نجاح يعتدّ به، بل يمكن القول (من دون خوف من الوقوع في خطأ كبير) إنها انطوت على مؤشّرات سلبية على طبيعة النظام السياسي الذي تتجّه نحوه سورية، من مركزة السلطة بيد الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، وجعله صاحب القرار الوحيد في البلاد. وقد جاء الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية ليزيد الطين بِلَّه على خلفية اعتماد معايير اجتماعية في اختيار الوزراء، واحتفاظ الرئيس الانتقالي برئاسة الوزارة، وتنصيب سبع شخصيات من هيئة تحرير الشام، كانوا وزراءَ في حكومة الإنقاذ في إدلب، أربعة منهم في وزارات سيادية. هذا في وقت تشير فيه المعطيات المحلّية والإقليمية والدولية إلى وجود تحدّياتٍ عديدةٍ، كبيرة وخطيرة، ستعترض طريق الحكومة الانتقالية، وتجعل عملها لحلّ المشكلات الداخلية والخارجية صعباً، يزيد في صعوبته اجتماع هذه التحدّيات في لحظة سياسية عاصفة ومتحرّكة.
أوّل هذه التحدّيات التنّوع الذي يعرفه الاجتماع السوري دينياً ومذهبياً وقومياً، تنّوع اجتماعي دفعته السياسات التمييزية طوال فترة حكم النظام البائد المديدة إلى الترّكز حول الذات والتحوّل إلى هُويَّاتٍ ومواقفَ سياسية متعارضة ومتناقضة، كرّستها وعمّقتها سياساته في القتل والتدمير والاستحواذ على خيرات البلاد، وترك المواطنين تحت وطأة العوز والجوع في العقد ونصف العقد الماضيين، وقد استفزّتها الإدارة الجديدة بخياراتها ذات اللون الواحد، وبسياساتها غير المكترثة بمطالبها وتطلّعاتها، ضخّمت هواجسها وحرّكت مخاوفها من المستقبل والمصير الذي ينتظرها، ودفعتها نحو التمترس والتطلّع إلى مصدر خارجي للحماية لتحقيق حقوق سياسية واقتصادية تحفظ اجتماعها وخصوصياته. وزاد في تعقيد الموقف وخطورته اعتماد الإدارة الجديدة على العرب السنة، ليس بتخويف أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى وأبناء القوميات غير العربية فقط، بل وبتحويل السُّنة طائفةً وحرساً إمبراطورياً للإدارة الجديدة، ما صعّد تطلعاتهم إلى السيطرة والاستنفار للدفاع عن سلطة غدت سلطتهم، تجسّد ذلك في نداء الفزعة وتبعاتها بقتل مئات المدنيين العلويين، وعمّق الاستقطاب بين الطوائف وزاد الاحتقان حدّةً.
ليست مواقف القوى السياسية، القومية والمذهبية، المعترضة على سياسات الإدارة الجديدة وتصوّراتها، خاصّة مطالباتها بنظام لامركزي/ اتحادي، أقلّ تأثيراً وعرقلةً لمهمّة مواجهة تحدّي التنّوع، وجعله أكثر تعقيداً وصعوبةً في ضوء تعدّد أسس ومرتكزات هذه المطالب، أسس قومية (الكرد والآشوريين السريان)، ومذهبية (الدروز والعلويين)، فمطالب قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا تتطابق مع النظام الاتحادي، فليس في النظام الاتحادي جيش خاصّ، ولا يغير من طبيعة الموقف عرضها وضع قواتها تحت إشراف وزارة الدفاع، طالما كانت الموافقة مقرونةً بالإبقاء على هياكلها وتشكيلاتها كما هي، وليس في النظام الاتحادي علاقات خارجية للأقاليم. تصور قيادة “قسد” أقرب إلى الاتحاد التعاهدي (الكونفدرالية) منه إلى النظام الاتحادي، في حين تقوم دعوات اللامركزية في الساحل والسويداء على أساس مذهبي، ما يجعلها دعوات لانقسام عمودي يفرّق أبناء الجنس الواحد (العرب)، ويدفعهم إلى مواجهات بشأن الموارد والمصالح. وهذا لا يشكّل الجانب الرئيس في الموضوع، إذ إن الجانب الأكثر تأثيراً في الموقف هو غياب أرضية ثقافية، ووعي سياسي، لقيام نظام اتحادي في سورية، وفي كلّ الدول العربية والإسلامية. يتجاهل دعاة الاتحادية ذلك وهم يكرّرون تعداد الدول التي فيها أنظمة سياسية اتحادية، يتجاهلون السياق التاريخي وثقافة الدولة والمصلحة العامة، التي كانت وما زالت سائدةً لدى مواطني هذه الدول، وهو ما نفتقده لدى مواطني سورية، والدول العربية والإسلامية، إذ لا إدراك للمصلحة العامّة والملكية العامّة. كان لافتاً ما حصل في العراق وسورية عند سقوط النظامين البائدين 2003 و2024، على التوالي، من نهب لممتلكات الدولة وإتلافٍ لمقارها، والأكثر دلالةً ومأساويةً ما حصل في قطاع غزّة من نهب للمساعدات الإنسانية قبل تفريغها من الشاحنات من الأسر الكبيرة والعصابات، في تجاهل تامّ لحق الشركاء في الوطن والمصير، وهم جميعاً في أتون مواجهة القتل والتدمير والخطر الوجودي، فالمنبّه الرئيس لتحرّك المواطنين في بلاد العرب والمسلمين، ليس المواطنة والشراكة في الوطن، بل القرابة، قرابة الدم، ما سيجعل الأقاليم ساحةَ صراع على المواقع والموارد والمصالح، كما هو حاصل في إقليم كردستان العراق، حيث الانقسام العمودي بين البارزانيين في أربيل، والطالبانيين في السليمانية، وحيث ما زال لكلّ قسم “البشمركة” الخاصّة، وجهاز مخابراته الخاصّ، ومطاره الخاصّ، وموارده الاقتصادية الخاصّة.
فالوضع ليس عدم حصول اندماج وطني في كيان واحد، بل أيضاً الدخول في مواجهات مباشرة، والتحالف مع قوى لا تريد للإقليم الخير، رغم الانتماء القومي، ورغم مرور أكثر من عقدَين على قيام الإقليم. لقد بقيت الأولوية في المجتمعات العربية والإسلامية لقرابة الدم. وهذا سيكون عامل تفجير في أيّ إقليم في ضوء الجغرافيا البشرية، حيث لا يوجد في سورية مناطق يسكنها مكوّن واحد، حيث التجاور والتشابك سيّد الموقف. فالمطالبة بنظام اتحادي فيها كثير من التبسيط، والموقف هنا لا يتعلق بالاتحادية في حد ذاتها، بل في علاقتها بالسياقات وبالبنى السياسية والثقافية والاجتماعية، فالأنظمة الاتحادية تحتاج قاعدةً قويةً من ثقافة الدولة، ومن الوعي بها وبمستدعياتها من إدراك للشراكة الوطنية والمصلحة العامّة والمصير المشترك.
لقد أطلق الاتفاق المبدئي، الذي وقّعه أحمد الشرع ومظلوم عبدي، آمالاً بالخروج بحلّ توافقي يُخرج البلاد من حالة الاستعصاء، لكنّ هذه الآمال بدأت بالتلاشي على خلفية صدور الإعلان الدستوري ومواده، التي وضعت جلّ الصلاحيات بيد الرئيس الانتقالي، وتشكيلة الحكومة الانتقالية التي اختير وزراؤها بتجاهل تامّ للقوى السياسية، وبالتذرّع بالخبرة والاختصاص. في هذا الإطار يمكن اعتبار الاتفاق بين أحزاب الوحدة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي على موقف سياسي موحّد، وإعلان تشكيل وفد موحّد للتفاوض مع السلطة الجديدة في دمشق، وسيلةً لتحسين بنود اتفاق الشرع عبدي أو التنصّل منه، بعد أن شعرت قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بأن الأمور لا تسير في اتجاه تحقيق مطالبها. واقع الحال أن مخاوف قيادة “قسد”، والكرد عامّةً، مبرّرة. فتوجّهات السلطة لا تضمن لا الحقوق ولا العدالة والمساواة، والعودة إلى التفاوض تستدعي إدراكاً للتوازنات والمخاطر الظاهرة والكامنة في حال عدم الاتفاق، ما يفرض اعتماد التوافق قاعدةً رئيسةً، والمرونة والقبول بنظام لامركزي مرن، يتيح حدّاً معقولاً من إدارة محلّية للمدن والمحافظات، والتركيز على التشاركية والمساواة، وضمان الحقوق في دولة مواطنة، ونظام قائم على التعدّد السياسي، والحرّيات الخاصة والعامة، وحرّية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات، والتنمية المتوازنة والخدمات في المحافظات، والانتخابات النزيهة، وصولاً إلى الحقّ في تشكيل الأحزاب والمنظّمات والنقابات… إلخ. فهذا ما تطيقه المرحلة، ويقبله العقل العملي، لتحاشي سفك الدماء والدمار.
أمّا ثاني التحدّيات في وجه الحكومة الانتقالية العتيدة، المطالب الإقليمية والدولية، وهي كثيرة ومتقاطعة في بعضها، ومتعارضة في بعضها الآخر. بعضها مقصودٌ لذاته وبعضها وسيلة للضغط على السلطة الجديدة لتحقيق هدفٍ معيّن أو كسب موطئ قدم في البلاد. وما جعل لهذه المطالب وزناً إضافياً ربط بعض هذه الدول رفع العقوبات بتنفيذها، ورفع العقوبات حاجة حياتية داهمة لأن عدم رفعها سيجعل إقلاع الاقتصاد، وتوفير المعيشة والخدمات، والبدء بإعادة الإعمار، ضرباً من المستحيل. وهنا تبرز أهمية الحكمة والإبداع والخيال الواسع في توظيف الطاقات كلّها، بما في ذلك السوريون في المهاجر، لوضع خطّة تتقاطع مع هذه المطالب من دون تطبيقها حرفياً، ما يستدعي العمل على تأسيس إجماع وطني حول هذه الخطّة، ويفرض الاتفاق مع أطراف الاجتماع الوطني على حلولٍ للتباينات والاختلافات أساسُه توازن المصالح والإقرار بحقوق متساوية، فمن دون الاحتماء بالإجماع الوطني القائم على الرضا لا يمكن مقاومة الضغوط الخارجية واحتواء مفاعيلها السلبية.
ثالث التحدّيات تحقيق سويّةٍ مقبولةٍ في مستويات المعيشة والخدمات، ومواجهة حالة الفقر والعوز الشديد، وملاحقة المتلاعبين بأقوات المواطنين من خلال اللعب بسعر صرف الليرة السورية، والتوقّف عن سياسة حبس السيولة التي شلّت الأسواق، وقادت إلى تضخّم سلعي، ما يستدعي تبنّي سياسة تشاركية بين القطاعين العامّ والخاصّ، بما في ذلك السوريون في الخارج، والسماح للقطاع الخاصّ بالعمل وفق أسس منصفة وعادلة تتيح له الربح من دون استغلال وجشع، من جهة، وتحميه، من جهة ثانية، من منافسات خارجية من دون إخلال بحاجات المواطنين للسلع. فالتشاركية وفتح السوق المنضبط أمام السلع الأجنبية يمكن أن تطلق عجلة الاقتصاد وتبعث الأمل في المجتمع.
تحتاج سورية إلى أبنائها كلّهم من دون تمييز أو إقصاء، من أجل إنجاح تجربة الانتقال السياسي، كما تحتاج إلى مرونة من الجميع، والاستعداد لإعادة النظر في المطالب والمواقف خدمةً للصالح العامّ، فمن دون المرونة والتكيّف مع الظروف، والتنازلات المتبادلة، سنذهب إلى صراعات وصدمات ليست في مصلحة أحد منّا.
العربي الجديد
———————————
===================