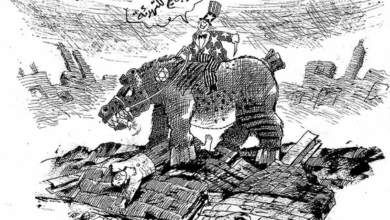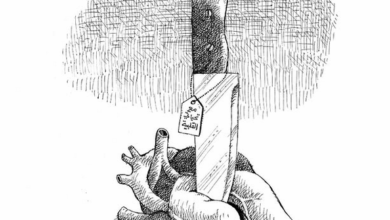الحكومة السورية الانتقالية: المهام، السير الذاتية للوزراء، مقالات وتحليلات تحديث 02 نيسان 2025

لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
——————————-
حكومة في سورية أم نهج؟/ مروان قبلان
02 ابريل 2025
تلتزم الإدارة السورية الجديدة، منذ وصولها إلى الحكم، مفاجأتنا في كلّ خطوة تخطوها نحو ملء الفراغ السياسي في البلاد. جديد مفاجآتها أخيراً تشكيل حكومة تضمّ كفاءاتٍ وطنيةً شابّة، متحمّسة للعمل، والنهوض بأعباء المهمّة الصعبة الملقاة على عاتقها. ورغم أن هذه الخطوة لاقت استحساناً في الشارع السوري، ودعماً عربياً ودولياً، ضروريَّين لمباشرة عملها، إلا أن ذلك كلّه لم يستطع إخفاء حقيقة أن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة جاء بهدف إرضاء الخارج (يشترط إشراك المرأة، والأقلّيات، وتلوين التشكيلة الحكومية بدل اقتصارها على لون واحد) أكثر منه استجابةً لاحتياجات الواقع السوري، فسورية لم تكن يوماً أحوج من الآن إلى حكومة شراكة وطنية، تتمثّل فيها قوىً وشخصياتٌ سياسيةٌ ومجتمعيةٌ ذات تأثيرٍ (ووزنٍ) في الشارع السوري، سوف تبرُز الحاجة إليها لمواجهة التحدّيات الكُبرى التي تنتظرنا في قادم الأيّام. ابتداع فكرة “حكومة تكنوقراط” كان يهدف تماماً إلى تجنّب هذه الشراكة، التي تنطوي على علاقةٍ ندّيةٍ بين قوى شاركت في الثورة وإسقاط النظام، والاستعاضة عنها بـ”حكومة كفاءات” مهمّتها تنفيذ الأوامر والتعليمات.
لا يحتاج بلد مزّقته الحرب والصراعات إلى حكومة كفاءات في هذه المرحلة، ولا يحقّق الشراكة فيها تجميلها بوزير من هنا أو وزيرة من هناك، تمثّل طائفةً من هنا، أو مكوّناً إثنياً من هناك (علماً أن الهدف المُعلَن للإدارة الجديدة رفض المحاصصة، للتغطية على مسعاها الحقيقي المتمثّل بإقصاء القوى السياسية والمجتمعية المؤثّرة، أو التي يمكن أن تصبح مؤثّرة). ما تحتاجه سورية الآن أكثر، أو ربّما مقدار حاجتها إلى إصلاح الطرق والمستشفيات، هو حفظ السلم الأهلي، ومعالجة الشروخ الاجتماعية العميقة التي لا تقتصر على العلاقة بين مكوّناتها الطائفية والإثنية المتنوّعة، بل تضرب حتى داخل المكوّن الواحد، وهذا لا يكون إلا باشراك ممثّلين فعليين من تلك المكوّنات، لهم ثقلهم ووزنهم فيها، خاصّة في ظلّ تعذّر تنظيم انتخابات عادلة (إذا قدّر لها أن تحصل يوماً).
بدأ هذا النهج (الإقصاء والتهميش) مع “مؤتمر النصر” في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، واستمرّ في مؤتمر “الحوار الوطني”، الذي جاء بعد “مشاورات” شكلية، استغرقت أسبوعاً، أجرتها اللجنة المسؤولة، وشملت أربعة آلاف شخص في مختلف المحافظات، لا نعرف صفتهم التمثيلية لملايين السوريين (!)، ثمّ جاء الإعلان الدستوري الذي فصّلته لجنة ضيّقة في مقاس السلطة، وأخيراً الحكومة التي شُكّلت من دون أدنى مشاورات مع القوى السياسية والمجتمعية السورية (هذا لا يحصل حتى في لبنان والعراق، اللذين يفترض أننا نرفض مذهبهما في تشكيل الحكومات). ويتوقّع لهذا النهج أن يستمرّ في اختيار الهيئة التشريعية، وتعيين المحكمة الدستورية، لتتركّز السلطات كلّها (أخيراً) في يد شخص واحد.
في البداية، كان التقدير (أو التبرير إن شئتم) أن الإدارة الجديدة (ربّما يجدر أن نسمّي نحن أيضاً الأمور بمسمّياتها الحقيقية، هيئة تحرير الشام) وجدت نفسها فجأةً في مقعد السلطة من دون خطّة أو برنامج بسبب الانهيار غير المتوقّع لنظام الأسد. بعد مرور أربعة أشهر، لم تعد هذه القراءة صالحةً، فهناك نهج واضح يسعى إلى تركيز السلطة في يد شخص واحد، وفصيل سياسي واحد. ولن ينجح هذا النهج في إعادة توحيد البلاد، ولا في رفع العقوبات عنها.
تحتاج سورية توافقات وطنية واسعة، وجهوداً صادقة لإشراك قواها السياسية والمجتمعية كلّها في إعادة بناء البلد، وهذا لا يتم من خلال استمرار النظر إلى السوريين باعتبارهم أفراداً، لا يعرفون التنظيم أو الاجتماع السياسي (المفارقة أن القوة السياسية الوحيدة الممثّلة بهذه الصفة في الحكومة هيئة تحرير الشام). لم يتأخّر الوقت على القيام بذلك. يمكن أن نعود إلى مراجعة الخطوات التي اتُّخذت، بما فيها الإعلان الدستوري، والدعوة إلى مؤتمر وطني سوري جامع، مهمّته الاتفاق على شكل الدولة ونظامها السياسي، وانتخاب جمعية وطنية تقوم مقام المشرّع، وتشكيل لجنة لكتابة الدستور الدائم، وحكومة وحدة وطنية، مدعومة بكفاءات لإدارة مرحلة انتقالية يُتَّفق على مدّتها. هذا فقط ما يعطي أحمد الشرع الشرعية المؤسّسية التي ينشدها، وما يعزّز حكمه بطريقة دستورية، وبإجماع وطني، وهو ما نريده مخلصين، لأنّنا نريد له أن ينجح، لا لشيء، إلا لأن فشله سيجرّ البلاد إلى كارثة نريد دفعها بكلّ ما نملك من قوّة.
العربي الجديد
———————————
الحكومة الانتقالية السورية الجديدة بين الطموح والتحديات
2 نيسان/أبريل ,2025
مقدمة:
جاء الإعلان عن الحكومة السورية الانتقالية لتكون المكوّن الثاني بعد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وأعلن تشكيلها يوم السبت 29 آذار/ مارس 2025، في القصر الجمهوري، ضمن تنظيم احتفالي نُقلت وقائعه مباشرة عبر التلفزيون، وتعدّ الحكومة “السلطة التنفيذية”، وهي المكوّن الثاني في ثلاثي السلطة، حيث يُنتظر تشكيل مجلس تشريعي مؤقت ليكون السلطة التشريعية، كما ينتظر تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون السلطة القضائية.
في حفل الإعلان عن الحكومة، ألقى الرئيس أحمد الشرع خطابًا افتتح به اللقاء، ووضّح فيه أهداف حكومته في المرحلة المقبلة، وتلا الخطابَ كلمات ألقاها كلُّ وزير على حدة، وضّح فيها أهداف وزراته في المرحلة المقبلة، وقد كانت أهدافهم طموحة جدًا، ولم تتضمن التشكيلة منصبَ رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لاعتماد النظام الرئاسي من النمط الأميركي، وفقًا للإعلان الدستوري، حيث يُشرف رئيس الجمهورية مباشرة على عمل الوزراء، لكن ما زال هناك حاجة إلى تعيين نائب لرئيس الجمهورية، يدير عمل مجلس الوزراء في حال غيابه.
جاء تشكيل الحكومة في فترةٍ تتسم بالترقّب الشديد لما ستكون عليه التشكيلة الوزارية التي وعد الشرع أن تكون شاملة ممثلة للجميع، وأنها ستكون وزارة كفاءات، وجاء الإعلان عن تشكيلها ضمن اهتمام داخلي واسع واهتمام إقليمي ودولي كبير، مع أن سورية ما زالت في واقع الحال مقسّمة عمليًا إلى عدة مناطق سيطرة، حيث تسيطر (قسد) في الشمال الشرقي وتضع شروطها رغم الوصول إلى اتفاق إطاري أبرمه كل من الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، وترفض قوًى في السويداء أن تمتدّ سلطة دمشق إليها، وتضع شروطها، ومن جانب آخر، تتدخل إسرائيل في الجنوب السوري، وتقوم قواتها بعمليات قصف بين حين وآخر وتتقدم قواتها في تلك المنطقة، ويستمر التوتر في منطقة الساحل وفي مدينة حمص، وقد أثارت الأحداث التي جرت في الساحل ردة فعل دولية واسعة، انعكست سلبًا على سمعة السلطة الانتقالية. ومن ناحية أخرى هناك احتكاكات مجتمعية، بين عناصر متشددة والمجتمعات السورية المحلية، ممّا يخلق حالة خوف في أوساط مجتمعية واسعة.
ضمن هذه الظروف، جاء إعلان تشكيل الوزارة الجديدة، وكان له دور كبير في التأثير في المناخ العام وفي اتجاه تطور الأحداث، سلبًا أو إيجابًا.
يُسجّل للحكومة الجديدة أنها أُعلنت بطريقة غير مألوفة في تجارب الحكومات السابقة، حيث جرى تنظيم جلسة عامة حضرها عدد كبير من الضيوف (نحو 300 شخصية، بينهم عدد قليل من السيدات)، ونُقلت الجلسة على الهواء مباشرة، وقدّم خلالها كل وزير رؤيته الأولية وبرنامجه المتوقع، وكانت برامج الوزراء طموحة جدًا. وإذا عُدّت هذه البرامج وعودًا، فسيكون من الصعب تحقيقها في ظلّ التحديات التي تواجهها سورية، داخليًا وخارجيًا، في ظل واقع سوري معقّد يتسم باستمرار الانقسام الجغرافي والسياسي. وربما أرادت الحكومة الجديدة توجيه رسائل إلى الداخل، مفادها الرغبة في المكاشفة والانفتاح، وأخرى إلى الخارج مفادها الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة أكثر شفافية، وإن لوحظ عدم استخدام مصطلح “الحكومة الانتقالية” خلال تلك الجلسة.
حول بنية الوزارة
تألّفت الحكومة من 23 وزارة، وكان عدد الوزارات فيها أقلَّ من عددها في حكومات النظام السابق (كان عددها في آخر حكومة 29 وزارة)، حيث جرى دمج بعض الوزارات، وألغيت وزارتا الموارد المائية، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، واستُحدثت وزارة جديدة للشباب والرياضة، وأخرى للطوارئ والكوارث، ويُلاحظ أن تقليص عدد الوزارات، من 29 إلى 23، عبر عمليات دمج، لا يعكس فقط توجّهًا تنظيميًا، بل قد يكون أيضًا استجابة واقعية لشحّ الموارد وتحديات التمويل، إذ يُعدّ ضغط النفقات الحكومية أحد الضرورات في ظلّ ضعف الموازنة العامة وصعوبة الحصول على دعم خارجي في حال عدم رفع العقوبات، ومن المرجّح أن هذا الدمج يعكس محاولة لتقليل الكلفة التشغيلية وزيادة الكفاءة، إلا أنّه قد يفرض تحديات إضافية على الوزراء الذين باتوا يتولّون حقائب مزدوجة، في ظل طواقم إدارية محدودة وبيروقراطية معقدة، لكن كان من الممكن أن تكون وزارة الطوارئ والكوارث هيئةً، بدلًا من وزارة، وهناك حاجة إلى توضيح مصير الوزارات التي أُلغيت، كالري والتجارة الداخلية، وإلى تحديد تبعيتها لأي وزارة ستكون.
ويُلاحظ أن هناك حضورًا قويًا لفئة الشباب في وزراء الحكومة، حيث راوحت أعمار الوزراء بين مواليد 1956 و1992. وقد غلب على الحكومة خريجو الجامعات الغربية، ومعظم الوزراء من خلفيات أكاديمية أو مهنية تقنية (أطباء، مهندسون، اقتصاديون)، ويشير التوزيع الجغرافي للوزراء إلى تركيز التمثيل في محافظات دمشق وريفها (5 وزراء)، وإدلب (4 وزراء)، وحلب ودير الزور (3 وزراء)، وحماة (وزيران)، ووزير من كلّ من القنيطرة، طرطوس، اللاذقية، حمص، الحسكة، مقابل غياب أي وزير من درعا والرقة. وقد غلب الطابع العربي السنّي على الحكومة، مع وجود وزيرَين من الأكراد، ووزير واحد لكل من الدروز، والمسيحيين، والعلويين، وغاب تمامًا التمثيل التركماني والإسماعيلي، ومعظم الوزراء محسوبون على التوجه الإسلامي، خاصة أولئك القادمين من هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ (9 من أصل 23، وتشمل أهم الوزارات “الوزارات السيادية”. إضافة إلى دمج وزارات النفط والكهرباء والماء في وزارة واحدة “وزارة الطاقة”، ووضع على رأسها محمد البشير. وضمت التشكيلة الغالبية (17 وزيرًا) من المعارضين المعروفين، و6 وزراء لم يكن لهم مواقف واضحة. وهناك وزيران شغلا مناصب وزارية في حكومات النظام السابق قبل الثورة، وعدة وزراء عملوا في حكومة الإنقاذ في إدلب سابقًا، أو في حكومة تصريف الأعمال التي تلت سقوط النظام، حيث احتفظ عدة وزراء بمناصبهم. واقتصرت مشاركة النساء على وزيرة واحدة، وهو ما عُدّ خطوة محدودة للغاية، في ظل ارتفاع المطالب النسوية بالمشاركة السياسية الفاعلة.
المواقف المحلية
عمومًا، ساد في الشارع السوري موجة من التفاؤل بوجوه جديدة وشابة، لكن بعض المواقف عبّرت عن خيبة أملها من ضعف التشاركية، وتهميش المرأة وغيرها. وعلى الرغم من حضور شخصيات تنتمي إلى خلفيات قومية ودينية متباينة داخل التشكيلة الوزارية، فلا يمكن اعتبار الحكومة ممثلة فعلًا لكلّ مكونات الشعب السوري، فالتعدد الشكلي لا يُغني عن التمثيل الحقيقي الذي لا يتحقق إلا من خلال صناديق الاقتراع، وهو أمرٌ غير ممكن في الظروف الراهنة. ومع ذلك، كان من الممكن إجراء نوع من المشاورات المجتمعية أو النخبوية قبل إعلان التشكيلة، مما ينمّي الشعور بمستوى تمثيل الحكومة، ويخفف حدة الرفض الذي ظهر من بعض الشخصيات والجهات لها، إلا أن ذلك لم يحدث، ما أثار تساؤلات حول أسلوب اختيار أعضائها، وقد غابت رموز المعارضة التقليدية (الائتلاف، الحكومة المؤقتة، هيئة التفاوض)، وعُدّ ذلك إشارةً إلى رغبة في القطيعة مع تلك التجارب، ولكن في المقابل لم يُستكمل ذلك بانفتاح كبير على قوى مدنية أو مجتمعية جديدة.
وبالنسبة إلى (قسد)، فقد أصدرت بيانًا حادّ اللهجة، رفضت فيه الحكومة الجديدة، ووصفتها بأنها “إقصائية وأحادية”، مؤكدة أنها لن تعترف بأي قرارات صادرة عنها، واعتبرت التشكيلة “عودة إلى مربع الاستئثار والهيمنة”. وكذلك الأمر بالنسبة للقوى الرئيسة في السويداء ولمجلس السويداء العسكري، ويهدد هذا الرفض بتوسيع فجوة الانقسام الوطني، ويقوّض فرص بناء شراكة وطنية شاملة، وإن استمرار الانقسام الجغرافي والسياسي، وتعثر حلّ ملفي قسد والسويداء، يظل التحدّي الأبرز الذي يقف أمام الحكومة في سعيها لإعادة بناء وحدة البلاد.
المواقف الدولية:
رحّبت العديد من الدول بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وعلى رأسها قطر وتركيا والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، والنروج، والأردن، والكويت، وفرنسا، وإيطاليا، وغيرها.
وبالنسبة للموقف الأميركي، فقد أُعلن أن الولايات المتحدة ستواصل تقييم سلوك السلطات المؤقتة وتحديد الخطوات التالية بناءً على تلك الإجراءات فيما يتعلق بالعقوبات، أي أن تعديل سياسة الولايات المتحدة سيكون مشروطًا باتخاذ مجموعة من الخطوات، منها نبذ الإرهاب وقمعه بالكامل، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي مناصب رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال أراضيها، واتخاذ خطوات جادة لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية بشكل يمكن التحقق منه، والمساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين وغيرهم من المختفين في سورية، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية في سورية.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد أبدى استعداده لدعم الحكومة الجديدة، ولم يتضمن بيان الاتحاد أي اشتراطات، على عكس البيانات السابقة، ما يعني أن دول الاتحاد مستعدة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة، بغض النظر عن سياسة أميركا تجاهها.
التحديات الموضوعية التي ستواجه الحكومة
تواجه الحكومة الجديدة مهمات وتحديات كبيرة، من إعادة الإعمار، إلى تأمين عودة اللاجئين، وصولًا إلى المهمة الأكثر صعوبة، وهي إعادة بناء اللحمة الوطنية في مجتمع ممزق ومنهك. ولا يمكن تحقيق ذلك دون استعادة وحدة البلاد، وإنهاء الانقسامات السياسية والمجتمعية، وهو ما يتطلب جهودًا تتجاوز مجرد الإدارة اليومية إلى مستوى بناء الثقة الوطنية.
العدالة الانتقالية والسلم المجتمعي: ما زالت قضايا العدالة الانتقالية غائبةً عن أجندة العمل الحكومي، مع أنها ضرورية لإعادة بناء الثقة المجتمعية بعد سنوات الانقسامات، فضلًا عن أن جهود تحقيق السلم الأهلي والمجتمعي لم تُفعّل بعد بالشكل الكافي، ما يُبقي على حالة التوتر بين المكونات المختلفة. ويعدّ هذا التحدي العقبةَ الأكبر أمام السلطة السورية الجديدة، فهو يشمل التوافقات الوطنية الرئيسة حول طبيعة النظام السياسي وطبيعة العقد الاجتماعي الجديد، وطبيعة السلطة السياسية القادمة في سورية، والمشاركة في السلطة، والموقف من الحريات العامة ومن الإدارة اللامركزية، والتغلب على الرغبة في الانتقام التي برزت خلال الشهور الماضية لدى بعض المجموعات.
تعدد مناطق السيطرة: حيث ما تزال بعض المناطق خاضعة لسيطرة فصائل مسلحة، مثل (قسد) في شرق الفرات، التي أبرمت مع دمشق اتفاقًا إطاريًا يحتاج إلى تفاصيل كثيرة هي موضع خلاف، ومثل السويداء التي لها وضع خاص، إذ ترفض أن تسيطر دمشق على السويداء وتقدّم مطالب تتعلق بشكل السلطة والحكم، وتبقى إسرائيل تعلن صراحة أنها تعمل على عدم امتداد سيطرة دمشق على جنوب سورية، وتقوم بغارات وضربات بين حين وآخر، وهناك أيضًا محافظة درعا وفصائلها، وخاصة قوات أحمد العودة التي لم تصل إلى اتفاق مع دمشق.
الأوضاع الأمنية: يعاني السكان حالة فوضى أمنية وسوء إدارة، ما يشكّل عائقًا مباشرًا أمام الحكومة في فرض القانون وهيبة المؤسسات، وإن غياب جهاز أمني مهني وموحّد يعقّد مهمة استعادة الاستقرار، وتنعكس الفوضى الأمنية في الأحداث التي جرت وما زالت تجري في الساحل وحمص، وكذلك في تعسف قوات الأمن تجاه المواطنين، حيث يتم اعتقال العديدين بطرق غير شرعية وبدون اتهامات محددة موثقة تستوجب الاعتقال، وبأمر من القاضي، ويُودع المعتقلون في السجون دون محاكمة، ولا يتمكّن ذووهم من الاستفسار عنهم. وبدأت حوادث العنف والاعتداءات والسرقات تتزايد نتيجة للأوضاع المادية المزرية ولغياب جسم شرطي كاف.
الدمار والبنية التحتية المنهارة: تواجه الحكومة تحديًا هائلًا في ظل الدمار واسع النطاق الذي شمل معظم البنى التحتية، ومن دون خطة متكاملة لإعادة الإعمار، ستبقى الخدمات الأساسية محدودة، وهو ما سينعكس مباشرة على مشروعية الحكومة في عيون المواطنين.
اللاجئون والنازحون: وتبلغ أعدادهم قرابة 12 مليون لاجئ، منهم أكثر من 5 ملايين نازح داخلي، وأكثر من 6 ملايين لاجئ، وخاصة في تركيا ولبنان والأردن ثم أوروبا، وهم عبء كبير يتطلب برامج عريضة وعملية تعاون إقليمي ودولي، ولا تبدو الأوضاع الحالية بعيون اللاجئين مشجعة للعودة إلى الوطن.
الاعتراف الخارجي: على الرغم من الترحيب الإقليمي والدولي بالإعلان عن الحكومة، فإن الاعتراف السياسي الكامل لا يزال غائبًا، فمعظم الدول تتعامل مع الحكومة بوصفها كيانًا “وظيفيًا”، وليس كبديل شرعي معترف به، وهذا التردد في الموقف الدولي يحدّ من قدرة الحكومة على الوصول إلى الدعم المالي والسياسي الضروري لاستقرارها.
التهديدات الخارجية: حيث تواجه الحكومة تهديدات مستمرة من قبل قوى إقليمية معادية أو غير متقبلة للتغيير السياسي في سورية، فضلًا عن أن استمرار الوجود العسكري الأجنبي، سواء النظامي أو غير النظامي، يضعف من قدرة الحكومة على التحكم في السيادة الوطنية.
موقع سورية الجيوسياسي: تُعدّ سورية ساحة تقاطع نفوذ إقليمي ودولي، ما يجعل أي حكومة عرضة لضغوطات متضاربة، والحكومة الجديدة مطالبة بصياغة سياسة خارجية متزنة، تحافظ على هوية البلاد، وتمنع الانزلاق في محاور إقليمية، مع تأمين الانفتاح على القوى الدولية الداعمة لإعادة الاستقرار.
تحديات شح الموارد:
إن التحديات الجسام التي تواجه الحكومة الانتقالية تتطلب موارد مادية وبشرية وصلاحيات واسعة، في حين إنها تعاني نقصًا شديدًا للموارد.
شحّ الموارد المادية: حيثتعاني الحكومة غيابًا شبه تام للموارد، في ظلّ العقوبات الدولية، وشح التمويل الخارجي، وسيجد الوزراء أنفسهم أمام واقع لا ينسجم مع الطموحات التي طُرحت خلال جلسة أداء القسم، وتحتاج سورية خلال سنواتها الأولى إلى مساعدات خارجية، إلى جانب تنمية الاستثمار الداخلي وإعادة إطلاق الاقتصاد المحلي، غير أن هذين المصدرين الداخلي والخارجي رهن برفع العقوبات التي فرضت على سورية منذ 2011، وتضم عقوبات عربية وأوروبية وأميركية وأممية، وهي تفرض على سورية قيودًا ثقيلة تمنع عنها المساعدات وتعوق الاستثمارات. لذا فإن أي نجاح حكومي سيبقى رهينًا بقدرة الحكومة على تنمية الموارد المحلية، وتفعيل آليات تمويل بديلة، والسعي للحصول على مساعدات خارجية، وهو ما يتطلب مرونة سياسية وانفتاحًا عقلانيًا على الواقعين الداخلي والخارجي.
شح الموارد البشرية: اعتمدت حكومة تصريف الأعمال على التوظيف السياسي بدل الكفاءة، ما أدى إلى فصل آلاف الكوادر الأساسية التي كانت تدير مؤسسات الدولة، وأحلّت محلّها كوادر شابة قليلة الخبرة، مما ترك أثره السلبي على أداء مختلف مؤسسات الدولة. وتحتاج الحكومة إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات، واستدعاء الكفاءات، ووقف التعيينات على أساس الولاء، وهي مهمة صعبة تتطلب إرادة سياسية حقيقية.
الصلاحيات: التحدي الأبرز ليس في القدرات، بل في حدود السلطة الممنوحة للحكومة، والسؤال الجوهري في هذا الشأن هو: هل تمتلك الحكومة الجديدة سلطة القرار على الأرض؟ وهل تستطيع ضبط الفصائل المسلحة التي ما زالت تسيطر على بعض المناطق؟ وهل لها الكلمة الفصل في القرارات السيادية؟ وإذا لم تُحسم هذه الأسئلة لصالح الحكومة، فإن تحقيق الاستقرار سيبقى حبرًا على ورق.
التباين داخل التشكيلة: قد يُعدّ تنوّع الحكومة نقطة قوة، إلا أنه يمثل تحديًا أيضًا في ظل اختلاف الخلفيات الأيديولوجية والمهنية للوزراء، ويبقى السؤال: هل ستستطيع الحكومة العمل بروح الفريق؟ وما مدى قدرة الرئيس الشرع على ضبط مسار العمل كفريق وطني جامع؟
كلّ هذه التحديات تؤكد على ضرورة أن تصدر الحكومة بيانًا عن برنامجها خلال المرحلة الانتقالية، وهي خمس سنوات، حسب الإعلان الدستوري، يتضمن الخطوط العامة للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تبغيه، وطبيعة العقد الاجتماعي الذي تنشده، وأن تحدد المراحل الزمنية لإنجاز برنامجها، وأن يتضمن آليات المتابعة ومعايير القياس، وليس هذا بالأمر البسيط لأن كل برنامج يعكس رؤية محددة ومصالح محددة.
خاتمة:
على الرغم من الملاحظات السابقة، فإن من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي على الحكومة الجديدة، فالتجربة لا تزال في بدايتها، والأمل -وإن كان حذرًا- لا يزال قائمًا في أن تتمكن هذه الحكومة من تحقيق بعض الإنجازات الملموسة، لا سيّما في الملفات الخدمية والمعيشية، والسوريون سيمنحون الحكومة مهلة غير معلنة، ولكنها ستكون حاسمة، ربما تصل إلى 6 أشهر، قبل أن تبدأ المحاسبة الشعبية، وخلال هذه الفترة، ستتم مراقبة الأداء في كل وزارة، ومتابعة مدى تنفيذ البرامج المعلنة خلال حفل الإعلان.
ويبقى السوريون، رغم كل الخيبات، شعبًا يراقب بعين مفتوحة وعقل يقظ، ينتظرون أي بارقة أمل تنقذهم من واقع الانقسام والحرمان، وهم يدركون أن الوقت لم يعد يحتمل التجريب أو التلاعب بالشعارات، فالنجاح هذه المرة ليس خيارًا إضافيًا، بل ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
تحميل الموضوع
مركز حرمون
———————————
المخاض السوري… ضرورة التنازلات المتبادلة والتوافق/ علي العبدالله
02 ابريل 2025
اكتملت المائة يوم الأولى على تسلّم الإدارة الجديدة السلطة في سورية، الفترة المعيارية المعتمدة في مناهج البحث السياسي لقياس مدى نجاح السلطة الحاكمة في إدارة البلاد، وتنفيذ برامج وخطط عمل تستجيب لمصالح المواطنين وتطلّعاتهم، واعتبار ذلك مؤشّراً على نجاحها في المتبقّي من فترة ولايتها… مرّت من دون نجاح يعتدّ به، بل يمكن القول (من دون خوف من الوقوع في خطأ كبير) إنها انطوت على مؤشّرات سلبية على طبيعة النظام السياسي الذي تتجّه نحوه سورية، من مركزة السلطة بيد الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، وجعله صاحب القرار الوحيد في البلاد. وقد جاء الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية ليزيد الطين بِلَّه على خلفية اعتماد معايير اجتماعية في اختيار الوزراء، واحتفاظ الرئيس الانتقالي برئاسة الوزارة، وتنصيب سبع شخصيات من هيئة تحرير الشام، كانوا وزراءَ في حكومة الإنقاذ في إدلب، أربعة منهم في وزارات سيادية. هذا في وقت تشير فيه المعطيات المحلّية والإقليمية والدولية إلى وجود تحدّياتٍ عديدةٍ، كبيرة وخطيرة، ستعترض طريق الحكومة الانتقالية، وتجعل عملها لحلّ المشكلات الداخلية والخارجية صعباً، يزيد في صعوبته اجتماع هذه التحدّيات في لحظة سياسية عاصفة ومتحرّكة.
أوّل هذه التحدّيات التنّوع الذي يعرفه الاجتماع السوري دينياً ومذهبياً وقومياً، تنّوع اجتماعي دفعته السياسات التمييزية طوال فترة حكم النظام البائد المديدة إلى الترّكز حول الذات والتحوّل إلى هُويَّاتٍ ومواقفَ سياسية متعارضة ومتناقضة، كرّستها وعمّقتها سياساته في القتل والتدمير والاستحواذ على خيرات البلاد، وترك المواطنين تحت وطأة العوز والجوع في العقد ونصف العقد الماضيين، وقد استفزّتها الإدارة الجديدة بخياراتها ذات اللون الواحد، وبسياساتها غير المكترثة بمطالبها وتطلّعاتها، ضخّمت هواجسها وحرّكت مخاوفها من المستقبل والمصير الذي ينتظرها، ودفعتها نحو التمترس والتطلّع إلى مصدر خارجي للحماية لتحقيق حقوق سياسية واقتصادية تحفظ اجتماعها وخصوصياته. وزاد في تعقيد الموقف وخطورته اعتماد الإدارة الجديدة على العرب السنة، ليس بتخويف أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى وأبناء القوميات غير العربية فقط، بل وبتحويل السُّنة طائفةً وحرساً إمبراطورياً للإدارة الجديدة، ما صعّد تطلعاتهم إلى السيطرة والاستنفار للدفاع عن سلطة غدت سلطتهم، تجسّد ذلك في نداء الفزعة وتبعاتها بقتل مئات المدنيين العلويين، وعمّق الاستقطاب بين الطوائف وزاد الاحتقان حدّةً.
ليست مواقف القوى السياسية، القومية والمذهبية، المعترضة على سياسات الإدارة الجديدة وتصوّراتها، خاصّة مطالباتها بنظام لامركزي/ اتحادي، أقلّ تأثيراً وعرقلةً لمهمّة مواجهة تحدّي التنّوع، وجعله أكثر تعقيداً وصعوبةً في ضوء تعدّد أسس ومرتكزات هذه المطالب، أسس قومية (الكرد والآشوريين السريان)، ومذهبية (الدروز والعلويين)، فمطالب قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا تتطابق مع النظام الاتحادي، فليس في النظام الاتحادي جيش خاصّ، ولا يغير من طبيعة الموقف عرضها وضع قواتها تحت إشراف وزارة الدفاع، طالما كانت الموافقة مقرونةً بالإبقاء على هياكلها وتشكيلاتها كما هي، وليس في النظام الاتحادي علاقات خارجية للأقاليم. تصور قيادة “قسد” أقرب إلى الاتحاد التعاهدي (الكونفدرالية) منه إلى النظام الاتحادي، في حين تقوم دعوات اللامركزية في الساحل والسويداء على أساس مذهبي، ما يجعلها دعوات لانقسام عمودي يفرّق أبناء الجنس الواحد (العرب)، ويدفعهم إلى مواجهات بشأن الموارد والمصالح. وهذا لا يشكّل الجانب الرئيس في الموضوع، إذ إن الجانب الأكثر تأثيراً في الموقف هو غياب أرضية ثقافية، ووعي سياسي، لقيام نظام اتحادي في سورية، وفي كلّ الدول العربية والإسلامية. يتجاهل دعاة الاتحادية ذلك وهم يكرّرون تعداد الدول التي فيها أنظمة سياسية اتحادية، يتجاهلون السياق التاريخي وثقافة الدولة والمصلحة العامة، التي كانت وما زالت سائدةً لدى مواطني هذه الدول، وهو ما نفتقده لدى مواطني سورية، والدول العربية والإسلامية، إذ لا إدراك للمصلحة العامّة والملكية العامّة. كان لافتاً ما حصل في العراق وسورية عند سقوط النظامين البائدين 2003 و2024، على التوالي، من نهب لممتلكات الدولة وإتلافٍ لمقارها، والأكثر دلالةً ومأساويةً ما حصل في قطاع غزّة من نهب للمساعدات الإنسانية قبل تفريغها من الشاحنات من الأسر الكبيرة والعصابات، في تجاهل تامّ لحق الشركاء في الوطن والمصير، وهم جميعاً في أتون مواجهة القتل والتدمير والخطر الوجودي، فالمنبّه الرئيس لتحرّك المواطنين في بلاد العرب والمسلمين، ليس المواطنة والشراكة في الوطن، بل القرابة، قرابة الدم، ما سيجعل الأقاليم ساحةَ صراع على المواقع والموارد والمصالح، كما هو حاصل في إقليم كردستان العراق، حيث الانقسام العمودي بين البارزانيين في أربيل، والطالبانيين في السليمانية، وحيث ما زال لكلّ قسم “البشمركة” الخاصّة، وجهاز مخابراته الخاصّ، ومطاره الخاصّ، وموارده الاقتصادية الخاصّة.
فالوضع ليس عدم حصول اندماج وطني في كيان واحد، بل أيضاً الدخول في مواجهات مباشرة، والتحالف مع قوى لا تريد للإقليم الخير، رغم الانتماء القومي، ورغم مرور أكثر من عقدَين على قيام الإقليم. لقد بقيت الأولوية في المجتمعات العربية والإسلامية لقرابة الدم. وهذا سيكون عامل تفجير في أيّ إقليم في ضوء الجغرافيا البشرية، حيث لا يوجد في سورية مناطق يسكنها مكوّن واحد، حيث التجاور والتشابك سيّد الموقف. فالمطالبة بنظام اتحادي فيها كثير من التبسيط، والموقف هنا لا يتعلق بالاتحادية في حد ذاتها، بل في علاقتها بالسياقات وبالبنى السياسية والثقافية والاجتماعية، فالأنظمة الاتحادية تحتاج قاعدةً قويةً من ثقافة الدولة، ومن الوعي بها وبمستدعياتها من إدراك للشراكة الوطنية والمصلحة العامّة والمصير المشترك.
لقد أطلق الاتفاق المبدئي، الذي وقّعه أحمد الشرع ومظلوم عبدي، آمالاً بالخروج بحلّ توافقي يُخرج البلاد من حالة الاستعصاء، لكنّ هذه الآمال بدأت بالتلاشي على خلفية صدور الإعلان الدستوري ومواده، التي وضعت جلّ الصلاحيات بيد الرئيس الانتقالي، وتشكيلة الحكومة الانتقالية التي اختير وزراؤها بتجاهل تامّ للقوى السياسية، وبالتذرّع بالخبرة والاختصاص. في هذا الإطار يمكن اعتبار الاتفاق بين أحزاب الوحدة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي على موقف سياسي موحّد، وإعلان تشكيل وفد موحّد للتفاوض مع السلطة الجديدة في دمشق، وسيلةً لتحسين بنود اتفاق الشرع عبدي أو التنصّل منه، بعد أن شعرت قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بأن الأمور لا تسير في اتجاه تحقيق مطالبها. واقع الحال أن مخاوف قيادة “قسد”، والكرد عامّةً، مبرّرة. فتوجّهات السلطة لا تضمن لا الحقوق ولا العدالة والمساواة، والعودة إلى التفاوض تستدعي إدراكاً للتوازنات والمخاطر الظاهرة والكامنة في حال عدم الاتفاق، ما يفرض اعتماد التوافق قاعدةً رئيسةً، والمرونة والقبول بنظام لامركزي مرن، يتيح حدّاً معقولاً من إدارة محلّية للمدن والمحافظات، والتركيز على التشاركية والمساواة، وضمان الحقوق في دولة مواطنة، ونظام قائم على التعدّد السياسي، والحرّيات الخاصة والعامة، وحرّية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات، والتنمية المتوازنة والخدمات في المحافظات، والانتخابات النزيهة، وصولاً إلى الحقّ في تشكيل الأحزاب والمنظّمات والنقابات… إلخ. فهذا ما تطيقه المرحلة، ويقبله العقل العملي، لتحاشي سفك الدماء والدمار.
أمّا ثاني التحدّيات في وجه الحكومة الانتقالية العتيدة، المطالب الإقليمية والدولية، وهي كثيرة ومتقاطعة في بعضها، ومتعارضة في بعضها الآخر. بعضها مقصودٌ لذاته وبعضها وسيلة للضغط على السلطة الجديدة لتحقيق هدفٍ معيّن أو كسب موطئ قدم في البلاد. وما جعل لهذه المطالب وزناً إضافياً ربط بعض هذه الدول رفع العقوبات بتنفيذها، ورفع العقوبات حاجة حياتية داهمة لأن عدم رفعها سيجعل إقلاع الاقتصاد، وتوفير المعيشة والخدمات، والبدء بإعادة الإعمار، ضرباً من المستحيل. وهنا تبرز أهمية الحكمة والإبداع والخيال الواسع في توظيف الطاقات كلّها، بما في ذلك السوريون في المهاجر، لوضع خطّة تتقاطع مع هذه المطالب من دون تطبيقها حرفياً، ما يستدعي العمل على تأسيس إجماع وطني حول هذه الخطّة، ويفرض الاتفاق مع أطراف الاجتماع الوطني على حلولٍ للتباينات والاختلافات أساسُه توازن المصالح والإقرار بحقوق متساوية، فمن دون الاحتماء بالإجماع الوطني القائم على الرضا لا يمكن مقاومة الضغوط الخارجية واحتواء مفاعيلها السلبية.
ثالث التحدّيات تحقيق سويّةٍ مقبولةٍ في مستويات المعيشة والخدمات، ومواجهة حالة الفقر والعوز الشديد، وملاحقة المتلاعبين بأقوات المواطنين من خلال اللعب بسعر صرف الليرة السورية، والتوقّف عن سياسة حبس السيولة التي شلّت الأسواق، وقادت إلى تضخّم سلعي، ما يستدعي تبنّي سياسة تشاركية بين القطاعين العامّ والخاصّ، بما في ذلك السوريون في الخارج، والسماح للقطاع الخاصّ بالعمل وفق أسس منصفة وعادلة تتيح له الربح من دون استغلال وجشع، من جهة، وتحميه، من جهة ثانية، من منافسات خارجية من دون إخلال بحاجات المواطنين للسلع. فالتشاركية وفتح السوق المنضبط أمام السلع الأجنبية يمكن أن تطلق عجلة الاقتصاد وتبعث الأمل في المجتمع.
تحتاج سورية إلى أبنائها كلّهم من دون تمييز أو إقصاء، من أجل إنجاح تجربة الانتقال السياسي، كما تحتاج إلى مرونة من الجميع، والاستعداد لإعادة النظر في المطالب والمواقف خدمةً للصالح العامّ، فمن دون المرونة والتكيّف مع الظروف، والتنازلات المتبادلة، سنذهب إلى صراعات وصدمات ليست في مصلحة أحد منّا.
العربي الجديد
———————
حكومة الشرع الأولى: الحقائب الأساسية للهيئة.. والثانوية لـ”التنوع”/ محمد الشيخ
الأربعاء 2025/04/02
كثيرة هي التفاصيل المرتبطة بالحكومة السورية الوليدة، لكن يمكن الملاحظة بأنها حاولت تحقيق نوع من التوازن بين “التكنوقراط” وتنوع المجتمع السوري، لجهة العرق والطائفة والجغرافيا، مع إسقاط الخلفيات السياسية، ما عدا 3 حقائب سيادية أساسية، و6 أخرى ذهبت لأشخاص محسوبين على هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها سابقاً في إدلب.
ولدت الحكومة السورية الانتقالية، الأولى بعد سقوط نظام الأسد، السبت الماضي، ضمن جلسة علنية في قصر الشعب في دمشق. وتتألف الحكومة من 23 وزيراً، من دون أن تتضمن منصب رئيس مجلس الوزراء، لأن الإعلان الدستوري المؤقت، اعتمد النظام الرئاسي، وبالتالي فإن الوزراء يتبعون مباشرة للرئيس السوري أحمد الشرع، وهو بذلك صاحب السلطة التنفيذية في الدولة.
وقال الشرع في كلمة بمناسبة عيد الفطر، الاثنين، إن الحكومة راعت قدر المستطاع اختيار الأكفّاء والتوسّع والانتشار والمحافظات وتنوّع المجتمع السوري. وأضاف “رفضنا المحاصصة الطائفية، وذهبنا باتجاه المشاركة، ولم نستجب لأي حالة من حالات التقسيم، لأن التقسيم السياسي سيدفع لحالة من التعطيل”.
إسقاط الخلفيات
يمكن ملاحظة تفاصيل ما قاله الشرع بشكل أساسي، من خلال اختيار وزراء النقل يعرب بدر، والاقتصاد محمد نضال الشعار، والتربية والتعليم محمد تركو، والزراعة أمجد بدر، والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.
فالوزير بدر المنحدر من اللاذقية، محسوب بشكل أو بآخر على النظام المخلوع، إذ أنه من كوادر حزب “البعث” سابقاً، كما سبق أن شغل حقيبة النقل، في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2011، لكن اختياره وقع على الأرجح، لطائفته العلوية، وتخصصه في مجال النقل، أي الموازنة ما بين “التكنوقراط” واللون الطائفي، وبالتالي تم إسقاط خلفيته السياسية.
وعلى المنوال نفسه، تم إغفال شغل الشعار منصب وزير الاقتصاد والتجارة بين العامين 2011 و2012، وكذلك الحال بالنسبة للوزير تركو الذي كان حتى الأشهر الأخيرة ما قبل سقوط النظام، يشغل نائب رئيس جامعة دمشق، مع تعذر معرفة علاقتهما بحزب “البعث” بشكل أساسي.
والمرجح أن اختيار تركو وقع لأنه كردي بشكل أساسي، وبالتالي تمثيل الأكراد في الحكومة، وهو ما غاب عن آخر 3 حكومات على عهد النظام المخلوع على الأقل، كما أنه غير محسوب سياسياً على التيارات والأحزاب الكردية أو على قوات سوريا الدمقراطية (قسد)، بينما السيرة الذاتية للوزير الشعار، كانت وراء اختياره بشكل أساسي.
التنوع الطائفي والجغرافي
أما الوزير أمجد بدر، فهو من الطائفة الدرزية، ومن المحسوبين على المجتمع المدني وحراك السويداء. وشغل سابقاً منصب مدير مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء، إلا أنه فُصل تعسفياً من منصبه عام 2014، بسبب معارضته للنظام ومشاركته في الحراك.
الوزيرة هند قبوات، محسوبة على منظمات المجتمع المدني، وهي من عائلة مسيحية دمشقية، كما كانت عضواً في هيئة التفاوض المعارضة. وتشير السيرة الذاتية للوزيرة، إلى أن اختيارها كان على الأرجح بناءً على خبرتها الطويلة بالتعامل مع المجتمع السوري، لا على شهادتها الأكاديمية، مع سبب جوهري آخر هو ديانتها، إضافة لكونها المرأة الوحيدة في التشكيلة الحكومية.
وبناء على ما سبق، فإن الحكومة الجديدة، تضمنت منح الطائفة العلوية حقيبة وزارية واحدة، ومثلها للدروز والأكراد والمسيحيين، بينما بالمقياس المذهبي، فإن 3 وزراء فقط من غير الطائفة السُنية، لأن الوزير تركو محسوب عليها، أي أن 20 حقيبة وزارية ذهبت للسُنة.
ولجهة التوزع المناطقي، حلّت العاصمة دمشق وإدلب في المرتبة الأولى، بـ4 حقائب وزارية لكل منهما، ثم أتت حلب وديرالزور بـ3 حقائب لكل محافظة، تليهما حماة بحقيبتين، ثم ريف دمشق وطرطوس والحسكة وحمص والسويداء والقنيطرة واللاذقية، بحقيبة واحدة لكل محافظة، فيما كان غياب درعا عن التمثيل لافتاً، وغابت الرقة كذلك.
الحقائب السيادية
لم تسلم التشكيلة الجديدة من الهجوم والانتقاد، على الرغم من محاولة الشرع تلوينها طائفياً مع تطعيمها بـ”التكنوقراط”، وبأشخاص من خارج هيئة تحرير الشام، كي لا توصف بحكومة اللون الواحد.
ويرى المهاجمون أن هيئة تحرير الشام وحكومة “الإنقاذ” التابعة لها، يسيطرون على التشكيلة الجديدة، عبر استئثار الحقائب السيادية الأساسية، الداخلية والخارجية والدفاع، إضافة إلى 6 وزارات أخرى هي العدل، الطاقة، الإدارة المحلية والبيئة، الأشغال العامة والإسكان، التنمية الإدارية والرياضة والشباب، وبالتالي الاستحواذ على 9 حقائب.
وأسند الشرع حقائب الداخلية لأنس خطاب، والخارجية لأسعد الشيباني، والدفاع لمرهف أبو قصرة، والعدل لمظهر الويس، وهم شخصيات كانت ضمن الهيكلية الأساسية لتحرير الشام.
بينما أسند وزارة الطاقة لمحمد البشير، والإدارة المحلية لمحمد عنجراني، والأشغال العامة لمصطفى عبد الرزاق، والتنمية الإدارية لمحمد اسكاف، والرياضة والشباب لمحمد حامض، وهم شخصيات كانوا ضمن هيكلية “حكومة الإنقاذ” سابقاً.
المدني
——————————
هل تقنع الحكومة السورية الجديدة الغرب برفع العقوبات؟/ أحمد زكريّا
2 أبريل 2025
منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، شهدت سوريا تحولات سياسية غير مسبوقة، أعادت رسم ملامح علاقتها بالمجتمع الدولي.
وبعد أشهر من الفوضى والتفاوض، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في 29 آذار/مارس 2025 عن تشكيل حكومة جديدة تضم 23 وزيرًا، وصفت بأنها “خطوة تاريخية” نحو الاستقرار والإصلاح.
لكن وسط هذا التفاؤل الحذر، يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن هذه التشكيلة من إقناع الدول الغربية برفع العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل السوريين منذ 2011؟ أم أن الطريق نحو ذلك سيظل طويلًا ومعقدًا، مشروطًا بمتطلبات سياسية وأمنية صارمة؟
خطوة نحو التمثيل الشامل أم استمرار للجدل؟
وجاء إعلان الحكومة الجديدة بعد ضغوط دولية مكثفة لتشكيل إدارة تكنوقراطية تعكس تنوع المجتمع السوري وتبتعد عن إرث نظام الأسد. التشكيلة، التي تضم ممثلين عن المسيحيين والدروز والكرد والعلويين، إلى جانب حضور نسائي محدود تمثل بتعيين هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، بدت محاولة لتلبية هذه المطالب، لكن تعيين شخصيات مثل أنس خطاب، الجهادي السابق ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، كوزير للداخلية، أثار تساؤلات حول مدى جدية التحول، خاصة مع بقائه على قوائم العقوبات الأممية.
وفي سياق متصل، دعا الشرع في نهاية آذار/مارس 2025، خلال قمة افتراضية مع قادة فرنسا ولبنان وقبرص واليونان، إلى رفع العقوبات، محذرًا من تأثيرها الكارثي. وقال في بيان الرئاسة: “بدأنا خطوات فعلية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء دولة قوية ومستقرة. رفع العقوبات ضرورة لدعم هذه الجهود”.
الموقف الأميركي والأوروبي: بين الترحيب الحذر والشروط
الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات مشددة مثل “قانون قيصر” منذ 2020، تبنت موقفًا يمزج بين الإيجابية والحذر. وأعلنت وزارة الخارجية أن العقوبات “قيد المراجعة”، مشيرة إلى دعمها لحكومة مدنية شاملة. وفي وقت سابق من 2025، أصدرت وزارة الخزانة تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر تسمح بمعاملات محدودة مع مؤسسات حكومية، لكن هذا لم يتجاوز مرحلة التجربة.
على الجانب الأوروبي، بدا النهج أكثر انفتاحًا، فالاتحاد الأوروبي، الذي علّق عقوباته لمدة عام في كانون الثاني/يناير 2025، أشار إلى أن الرفع الكامل مرهون بالتقدم الملموس.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس: “الحكومة الجديدة خطوة نحو الاستقرار، ونحن مستعدون لتخفيف العقوبات تدريجيًا، لكن هذا مشروط بالتزام الحكومة بحقوق الإنسان والإصلاحات”.
بدورها، رحبت فرنسا بالتشكيلة في 30 آذار/مارس 2025، معتبرةً أنها “بداية مرحلة جديدة”، بينما قدمت ألمانيا خطة دعم من ثماني نقاط تشمل إعادة الإعمار.
كمل أن دول مثل كندا وسويسرا والمملكة المتحدة اتخذت خطوات عملية منذ منتصف آذار/مارس الماضي، كتخفيف القيود المصرفية وإزالة 24 كيانًا سوريًا من قوائم العقوبات البريطانية، مما يعكس استعدادًا أكبر لدعم التعافي.
المشهد الدولي: تباين في النهج وتأثير على السوريين
وقبل الخوض في آراء المحللين، يجدر بنا التوقف عند السياق الأوسع: إن العقوبات الغربية، التي فُرضت كرد على انتهاكات نظام الأسد، قد أثرت بشدة على الاقتصاد السوري، مع انهيار الليرة وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 80% بحسب تقارير الأمم المتحدة.
التشكيلة الجديدة، رغم إثارتها للجدل، حظيت بترحيب دولي نسبي، لكن التباين بين الموقف الأميركي الحذر والمرونة الأوروبية يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير: كيف تثبت جديتها دون أن تُنظر إليها كأداة لتنفيذ أجندات خارجية؟
أوروبا تتقدم وأمريكا تتأخر
في هذا السياق، يقدم فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي في تصريح لـ”الترا سوريا”، تحليلاً يرصد التباين بين النهجين الأوروبي والأميركي. يقول: “عندما لاحظنا أن الدول الأوروبية رحبت بالحكومة الانتقالية الجديدة واعتبرتها خطوة إيجابية، كان ذلك بعد أن سبق لهذه الدول أن خففت العقوبات عن دمشق قبل تشكيلها، كما أصدرت قرارات بزيادة الدعم واستخدام أموال الأسد المصادرة لمشاريع التنمية وإعادة الإعمار”.
وأضاف: “أما الولايات المتحدة فموقفها مختلف ومتأخر، ورغم ترحيبها بالحكومة الجديدة، فهي ترى أن هذا غير كافٍ لرفع العقوبات، حيث تتبنى أميركا تصريحات إيجابية لكن بحذر شديد، تربط الرفع بشروط مثل محاربة النفوذ الإيراني، تقليص العلاقات مع روسيا، وتدمير أسلحة الدمار الشامل”. ويرى بلال أن أوروبا بدأت بتحويل الأموال المجمدة لدعم البنية التحتية، بينما يعيق الحذر الأميركي تقدمًا أسرع، حسب تعبيره.
وتشير التقارير إلى أن العقوبات، رغم استهدافها لنظام الأسد سابقًا، أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث بات أكثر من 12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
من جهتها، تواجه الحكومة الجديدة، التي تسعى لاستعادة الثقة الدولية، ضغوطًا داخلية لتحسين الأوضاع، بينما تتأرجح بين تلبية مطالب الغرب وحماية السيادة الوطنية.
العقوبات كأداة ضغط والتحديات المستقبلية
عبد العزيز دالاتي، نائب مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، يحذر من تبعات استمرار العقوبات على الشعب السوري. يقول لـ”الترا سوريا”: “بعد سقوط نظام الأسد، الذي كان السبب الرئيسي وراء العقوبات، كان من المتوقع رفعها لتخفيف معاناة الشعب”.
وتابع: “لكن استمرارها يُنظر إليه من وجهة نظر السوريين كابتزاز سياسي لفرض تنازلات، خاصةً مع ربط بعض الدول الرفع بشروط مثل الإصلاحات وحماية الأقليات، وربما تنازلات سرية غير معلنة، وهذا التأخير يزيد من الأزمة الاقتصادية والإنسانية، ويحرم السوريين من بداية جديدة كانوا يأملونها”. كما أعرب عن اعتقاده بأن الغرب قد يستخدم العقوبات كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، مما يعقد مسار التعافي.
تتجاوز التحديات أمام الحكومة الجديدة مجرد تشكيلها، إذ يتعين عليها التعامل مع ملفات معقدة كالنفوذ الإيراني والروسي، وتصنيف “هيئة تحرير الشام” على قوائم الإرهاب، إضافةً إلى إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي. هذه العوامل ستحدد مدى نجاحها في تخفيف العقوبات أو رفعها كليًا.
الكاتب والصحفي باسل المحمد يرى أن الحكومة الجديدة تمثل بداية واعدة لكنها ليست كافية، ويوضح لـ”الترا سوريا”: تشكيل الحكومة السورية الجديدة يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار السياسي في سوريا، وقد يساهم في تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد النظام السابق، وقد أبدت دول أوروبية والولايات المتحدة ترحيبًا بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة تتكون من تكنوقراط، مما يعزز فرص مراجعة هذه العقوبات، ومع ذلك، فإن رفعها بالكامل لن يكون فوريًا أو دون شروط”.
وتابع: “الولايات المتحدة تشترط تحقيق ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، محاربة الإرهاب، ثانيًا، ضمان دور الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب، وثالثًا، تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، وهو هدف تسعى إليه الحكومة الجديدة نفسها”.
ورأى أن: “الدول الأوروبية، تركز على قضايا حقوق الإنسان والحريات، بالإضافة إلى ضمان تمثيل أوسع للطوائف والأقليات في العملية السياسية، وقد حاولت الحكومة الجديدة تحقيق هذا التوازن عبر تشكيل وزاري يعكس تنوع المجتمع السوري، حيث تمثلت الطوائف مثل الدروز والعلويين والكرد في الحكومة بناءً على الكفاءة الوطنية، ومع ذلك، تشترط أوروبا أيضًا تقليص النفوذ الروسي وإنهاء وجود القواعد الروسية في سوريا، وهو أمر قد يشكل تحديًا كبيرًا”.
واعتبر المحمد أنه: “على الرغم من الجهود المبذولة، فإن رفع العقوبات بشكل كامل يعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات شاملة ومستدامة في المجالات السياسية والأمنية. وطالما بقيت هيئة تحرير الشام وقادتها مصنفين على قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستظل العقوبات قائمة جزئيًا أو كليًا”.
خطوة إلى الأمام لكن المسافة طويلة
تشكيلة الحكومة السورية الجديدة فتحت بابًا للتفاؤل، لكنها لم تُقنع الغرب بعد برفع العقوبات كليًا، حيث إن أوروبا تتقدم بخطوات عملية مثل تخفيف العقوبات ودعم الإعمار، بينما تظل أميركا متمسكة بشروط صارمة، ومن هنا فإن التحدي الأكبر أمام الشرع يكمن في إثبات أن حكومته قادرة على الإصلاح الشامل، مع التوفيق بين مطالب الغرب وحاجات الشعب. وحتى ذلك الحين، يبقى السوريون عالقين بين آمال التغيير وأعباء واقع قد يطول أمده، وفق مراقبين.
الترا سوريا
—————————
حكومة سورية بمهمات صعبة وظروف استثنائية/ رامي الخليفة العلي
الأربعاء 02 أبريل 2025
في تطور لافت ومهم، جاء الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الانتقالية متزامنًا مع عيد الفطر السعيد، ما أضفى على الحدث بعدًا رمزيًا وأملًا ببداية جديدة في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي تمر بها البلاد. لقد جاء هذا الإعلان تلبيةً لمطالب داخلية وخارجية بضرورة إشراك كافة مكونات الشعب السوري في العملية السياسية، وهو ما حرصت القيادة السورية على تأكيده منذ البداية. ولا شك أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون في غاية الصعوبة نظرًا لضخامة التحديات التي تنتظرها، وفي مقدمتها التحدي الأمني الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد، فضلًا عن التحدي السياسي المتمثل في توحيد مكونات الشعب السوري وتحقيق حالة من الوحدة الوطنية وفرض سلطة الدولة السورية على كامل التراب الوطني، وهي مهمة شاقة نظرًا لاستمرار وجود تشكيلات عسكرية على الأرض. الاتفاق مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) شكّل خطوة مهمة على طريق لمّ الشمل، لكن تطبيقه على أرض الواقع يواجه صعوبات كبيرة وخلافات متزايدة، ظهرت بشكل أوضح في الأسابيع الماضية. كما أن الجنوب السوري لا يزال يمثل مصدر قلق بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من جهة، والخلافات الداخلية في محافظة السويداء من جهة أخرى، خاصة مع بروز الخلاف مع الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، وهو خلاف بات يُستغل سياسيًا من قبل أطراف خارجية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في منطقة الساحل للتعامل مع التحديات الأمنية، إلا أن بقايا التوتر لا تزال حاضرة، في انتظار ما ستسفر عنه أعمال لجنتي التحقيق والمصالحة الوطنية. أما اقتصاديًا، فالمهمة تبدو أكثر تعقيدًا في ظل الإفلاس شبه الكامل لخزائن الدولة واستمرار العقوبات الغربية، وخصوصًا الأمريكية، رغم بعض التسهيلات المحدودة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. إعادة إنعاش الاقتصاد السوري تتطلب جهودًا هائلة ووقتًا طويلًا نظرًا لغياب البنية التحتية وتعدد الأزمات الهيكلية. وفي حين أن العلاقات الخارجية لسوريا تشهد بعض التحسن، بعد الدعم الكبير من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فإن الاشتراطات الدولية، لا سيما من واشنطن وبروكسل، لا تزال عائقًا أمام انفتاح كامل من المجتمع الدولي. من الإشارات الإيجابية أن الشارع السوري، رغم معاناته، يعبّر عن دعم ملموس للحكومة الجديدة، كما أن بعض الانتقادات الداخلية، وإن كانت حادة، تعكس حجم الرهانات الموضوعة على عاتقها. ولعل قبول هذه المهمة في هذا التوقيت الصعب يُعد بحد ذاته خطوة شجاعة، إذ إن حجم التحديات يفوق قدرات أي حكومة مهما كانت كفاءتها. ورغم ذلك، فإن تشكيل هذه الحكومة يمثّل خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، ويجب منحها الفرصة للعمل وتحقيق ما تعد به، على أمل أن تكون بالفعل بداية لمسار جديد يعيد لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها، ويضعها على طريق التعافي الشامل.
عكاظ السعودية
—————————
هل حصل الشرع وحكومته الجديدة على الاعتراف الدولي؟/ منهل عروب
2025.04.02
قبل عدة أسابيع بدت الشكوك قوية في عدم حضور وزير الخارجية الشيباني مؤتمر بروكسل للمانحين. الغياب له دلالات كبيرة في اهتزاز علاقة النظام الجديد بالقوى الدولية الفاعلة، خصوصاً الغربية: الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. تعززت تلك الشكوك بتصريحات الخارجية، التي رفضت ربط المؤتمر بقرارات تتصادم مع السيادة السورية، خصوصاً أن ذلك الرفض خرج قبل يومين من انعقاد المؤتمر.
عدد من الصحفيين والناشطين السوريين حذّر من تلك اللغة الخشبية التي تذكرنا بخطاب الممانعة الناري في عهد الأسد، وأن الدولة السورية الوليدة أضعف من أن تتفاوض على بنود، وتنتزع تنازلات في المحافل الدولية. ولكن ما حدث تالياً من حضور الشيباني إلى المؤتمر، وإعلان بنود أولية من المانحين طرح مقاربة أخرى لطبيعة العلاقة الغربية مع النظام الجديد، أو ما يريده الغرب من دمشق.
صحيح أن الموقف أو لنقل المواقف الأميركية المتعددة ملتبسة وغير واضحة: فمن تصريح الخارجية الأميركية التي تريد حكومة أكثر تنوعاً، وتريد أن ترى تقدماً في العملية الدستورية، إلى ويتكوف موفد ترامب للشرق الأوسط الذي يريد تعاوناً مع دمشق لإحلال السلام في الشرق الأوسط؛ ـ وهو يقصد المحور الإسرائيلي ـ، إلى مقترحات لبعض المشرعين الأميركيين عن ضرورة رفع العقوبات الأميركية لتحريك عجلة الاقتصاد السوري المتهالك. ولكن اللافت أنها كلّها من وجه آخر لا تطعن في شرعية النظام في دمشق، وإنما في ممارسة الضغوط لضمان الانفكاك عن “هيئة تحرير الشام” وفكرة الجهاد المعولم، إضافة إلى شروط أخرى ترتبط بالأهداف الأميركية الاستراتيجية في المنطقة، أكثر مما يتعلّق بنظام دمشق وبيته الداخلي. يؤكد ذلك عملياً دفع الإدارة الأميركية لـ”قسد” على إبرام “اتفاق ما” مع الحكومة المركزية. وهذا الاتفاق الذي سيق على عجل، يؤكد اعتبار واشنطن شرعية حكومة دمشق رغم التحفظات.
لم يخالف الموقف الأوروبي نظيره الأميركي. فبعد مؤتمر بروكسل، توجهت وزيرة الخارجية الألمانية مباشرة إلى دمشق. الطلبات الأوروبية مشابهة للأميركية، يضاف إليها موضوع اللاجئين السوريين في أوروبا. وهذا ربما يفسر حضور الشيباني لمؤتمر بروكسل، الذي ترافق مع تسريبات صحيفة بيلد الألمانية عن مفاوضات سرية بين دمشق وبرلين بشأن عودة اللاجئين، تلاه موعد زيارة لوزيرة الداخلية الألمانية تمّ تأجيلها لاعتبارات أمنية. وكما نعلم فإن هذه المفاوضات تتم باسم الأوروبيين عموماً، رغم المشاكسات الفرنسية في الجزيرة السورية؛ لأن أي اتفاق بهذا الخصوص سوف يتم تحت سقف الاتحاد الأوروبي وقوانينه الخاصة باللجوء.
المفاوضات حسب الصحف الألمانية ستتركز على تمويل بديل لإعادة الإعمار، ريثما يتم حلحلة ملف العقوبات الدولية، والأميركية منها خصوصاً. البدائل مشابهة لما كانت عليه على عهد النظام البائد: برامج التعافي المبكر، تمويل الجمعيات الخيرية والتعليمية، دعم القطاع الصحي إضافة إلى وصول محدود للبنك المركزي لدعم البنية التحتية الأساسية من كهرباء وصحة كما صرحت وزيرة الخارجية الألمانية. إعادة اللاجئين أو الحدّ من موجة اللجوء السوري، والتعاون الأمني في ذلك الملف سيكون على طاولة أي محادثات أوروبية ـ سورية. فقد حضرت وزيرة الخارجية الألمانية افتتاح سفارتها في دمشق، رغم التقييمات الأمنية الخطرة. ذلك الاستعجال الذي يدفع نحو تطبيع العلاقات ورفع سوية التبادل الدبلوماسي رغم العقبات، يعطينا فكرة عن الاتجاه والمدى الذي ترغب ألمانيا ومن خلفها أوروبا الذهاب فيه. فموضوع اللجوء أصبح من صلب السياسة الداخلية الألمانية، ويهدد بتفكك الاتحاد الأوروبي. ورغبة الأوروبيين في استقرارا المنطقة تعلو على كافة الصراعات والمشاكل الأخرى.
طبعا لم تخفِ الوزيرة أهدافها وطلباتها في دمشق: الاستقرار ومكافحة التطرف وضبط الفصائل تحت سلطة الدولة، ضبط الجهاديين، وعودة الخدمات الأساسية. وهنا بيت القصيد؛ فالاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية يتيح للدولة الألمانية إعادة تقييم الوضع في سوريا وتصنيفها دولة آمنة، مما يوقف طلبات اللجوء قانونياً وتستطيع إعادة اللاجئين الذين يحملون الإقامة المؤقتة، مما يسحب هذه الورقة من أحزاب اليمين المتطرف، ويقدمها إنجازاً يحدّ من تأييده. المهم هنا أن ألمانيا ترى في نظام دمشق الآن شريكاً قوياً وقادراً على ضبط الأوضاع على الأرض، وقادراً على إبرام الاتفاقات وتنفيذها.
تجدر الإشارة هنا في بند بناء الشراكة والموثوقية طلب الوزيرة “ضبط الفصائل الجهادية”. فمن غير المألوف الحديث عن الأمور الأمنية علناً وخصوصاً ما يتعلق بالفصائل الجهادية. وهذا من الاستعجال الأوروبي لإنجاز أكبر قدر من الخطوات على صعيد اللجوء في سبيل التفرّغ للصراع الروسي. الرغبة الأوروبية هذه دفعتهم لتفهم أحداث الساحل وتوجيه إدانة “منضبطة” للأخطاء التي جرت، وعدم الاستعجال في إطلاق الاتهامات ضد الحكومة السورية بارتكاب مجازر جماعية، وإنما أعطته التوصيف الحقيقي، مع إدانة حوادث القتل التي جرت من أي طرف كان.
مع إعلان التشكيل الحكومي كانت ألمانيا من أولى المرحبين بالحكومة الجديدة. أعلن المبعوث الألماني إلى سوريا، ستفن شنيك، عن استعداد بلاده لدعم السوريين في “مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم”. القبول الإقليمي والإشادة الأوروبية تبني رصيداً جديداً لدى نظام دمشق، ويفتح أبواباً أخرى على صعيد العلاقات الدبلوماسية والانفتاح الدولي على دمشق. وهكذا يكون الرئيس الشرع قد نجح حتى الآن في ثلاثة اختبارات: إسقاط نظام الأسد بأقل قدر من الفوضى والدم، تشكيل حكومة تكنوقراط مبشرة وواعدة وبذلك ضمن عدم سقوط الدولة السورية برحيل النظام السابق، وقبول القوى الإقليمية وجزء من المجتمع الدولي بسوريا ونظامها الجديد. فهل تفتح هذه الخطوات الباب مستقبلاً أمام الاعتراف الدولي الكامل؟
تلفزيون سوريا
—————————–
رغم الترحيب بالحكومة الجديدة.. لماذا يؤجل الغرب رفع العقوبات عن سوريا؟/ سامر القطريب
2025.04.02
تؤجل دول غربية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وقبرص، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، رغم ترحيبها بالحكومة الجديدة التي تصفها واشنطن بـ “التكنوقراطية”. وتربط هذه الدول قرارها بشروط سياسية تتعلق بـ “تمثيل الأقليات” و”وقف الانتهاكات” وغيرها من الملفات الحقوقية، لكن التصريحات والتحركات الإقليمية تشير إلى دوافع أعمق تتصل بالمصالح الجيوسياسية وسباق السيطرة على موارد شرقي المتوسط.
تسعى قوى إقليمية ودولية إلى ترسيخ نفوذها في الحوض البحري الغني بالغاز، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التحولات السياسية في دمشق لتأمين ترتيبات تضمن مصالحهم في المنطقة. ومع غياب توافق حول النفوذ البحري وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، يتحول ملف العقوبات إلى ورقة ضغط في لعبة موازين القوى، أكثر منه أداة لتحفيز العملية الانتقالية في سوريا.
تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية
إلى احتمالية وجود نحو 122 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز في حوض شرقي المتوسط، إضافة إلى نحو 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج. وتضم هذه المنطقة المياه الإقليمية السورية، التي يُعتقد أنها تحتوي على احتياطيات كبيرة غير مستغلة تضاهي التكوينات الغنية بالموارد قبالة سواحل مصر وقبرص ودولة الاحتلال.
أميركا تراجع.. وإسرائيل تضغط
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن جويل رايبورن سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بما في ذلك سوريا، وأكد أن واشنطن تراجع العقوبات المفروضة على سوريا. وفي تصريح خاص لـ”تلفزيون سوريا”، أوضح المتحدث أن القرار بشأن السياسة الأميركية في سوريا بيد الرئيس دونالد ترامب، وأن النقاشات مستمرة يوميًا داخل الإدارة الأميركية حول الملف السوري.
أكد المتحدث على رفض التدخلات الخارجية، وأعرب عن أمل واشنطن في أن تقيم سوريا علاقات جيدة مع دول الجوار. واعتبر أن “الشعب السوري هو من يقيم الحكومة الجديدة”، مضيفًا أن واشنطن ترى الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط. كما شدد على ضرورة استبعاد المقاتلين الأجانب ومنع النفوذ الإيراني، وتمكين السلطات الجديدة من السيطرة على كامل الأراضي السورية.
لكن خلف هذه التصريحات، تقف حسابات أوسع ترتبط بمصالح الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى للتحكم بمسار الغاز في شرقي المتوسط. فمشروع “إيست ميد” الذي يهدف إلى نقل الغاز من شرقي المتوسط إلى أوروبا عبر اليونان، تشارك فيه شركات إسرائيلية وأوروبية وأميركية، ويُنظر إليه كأداة لتقليص دور تركيا وروسيا في توريد الطاقة إلى أوروبا، وفق المركز العربي
للأبحاث ودراسة السياسات. ويرتبط المشروع بأنبوب بحري بطول 1300 كيلومتر يصل إلى جنوبي اليونان، يتفرع إلى أنبوب بري بطول 600 كيلومتر نحو غربها، ومنه إلى إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بقدرة نقل تقارب 10 مليارات متر مكعب سنويًا.
قبرص: لا رفع دائما للعقوبات
أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس أن أي رفع للعقوبات عن سوريا “لن يكون دائما”، بل سيُربط بتطورات في ثلاث قضايا أساسية: تشكيل حكومة شاملة، وقف استهداف السكان المدنيين، واحترام القانون الدولي، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وخلال قداس في ذكرى تأسيس منظمة “إيوكا”، شدد خريستودوليديس على أن هذه العوامل صارت شروطا نصية يجب أن تتحقق قبل بحث أي تخفيف للعقوبات. كما أشار إلى أهمية التزام سوريا بالقانون الدولي البحري، في ظل خلافات حادة بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب في شرق المتوسط.
وفي 24 من شباط الماضي، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على سوريا، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.
وقرر المجلس الأوروبي بشكل خاص الآتي:
تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى.
إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.
ألمانيا: سحب الروس شرط أول
بعد سقوط نظام بشار الأسد، زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دمشق، ودعت إلى إخلاء القواعد العسكرية الروسية ومغادرة سوريا. وفي وقت لاحق من كانون الثاني، أكد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، أن روسيا “تشكل أكبر تهديد للأمن الأوروبي في المستقبل المنظور”، وطالب بإغلاق القواعد الروسية وسحب القوات.
وقال ليندنر في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” إن احترام وحدة الأراضي السورية يجب أن يشمل جميع الأطراف، وخاصة روسيا. وأوضح أن الروس موجودون في سوريا لخدمة مصالحهم في البحر المتوسط وليبيا وأفريقيا، مؤكدا أن الوجود العسكري الروسي يهدد أمن أوروبا ويؤثر على الاستقرار الإقليمي.
فرنسا: خريطة طريق مشروطة
أصدر قصر الإليزيه الفرنسي “خريطة طريق” تتضمن دعما اقتصاديا ورفعا تدريجيا للعقوبات، مقابل خطوات واضحة من الحكومة السورية الجديدة. جاءت هذه المبادرة بعد قمة خماسية استضافتها باريس بمشاركة سوريا ولبنان وقبرص واليونان، وشارك فيها رئيس سوريا الجديد أحمد الشرع عبر الفيديو.
وبحث القادة خلال القمة قضايا عدة أبرزها اللاجئون، ترسيم الحدود اللبنانية السورية، وضمان استقرار المنطقة. وأعرب القادة الأوروبيون عن دعمهم لترسيم الحدود البحرية السورية وفق القانون الدولي البحري، وإنشاء لجان متخصصة لضمان مصالح الجيران الأوروبيين.
وفي السياق، يجري وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زيارة رسمية إلى فرنسا اليوم الأربعاء، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي جان نويل بارو، حيث من المقرر أن تتناول المباحثات عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف السوري.
تركيا والصفقة البحرية
في كانون الأول 2024، أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن نية بلاده التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة حول المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتهدف أنقرة إلى الاستفادة من سقوط الأسد لإلغاء اتفاقات سابقة منحت الروس والهنود حقوق التنقيب، وفرض شراكة جديدة تضمن مطالبها البحرية.
وتسعى تركيا لتوسيع نفوذها في شرق المتوسط، لكنها تواجه معارضة من اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر. فهذه الدول أنشأت منتدى غاز شرق المتوسط عام 2019 لتنسيق تسويق الغاز إلى أوروبا، واستبعدت تركيا من المشروع. كما وقّعت اليونان ومصر اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية، وهو ما ترفضه أنقرة وتعتبره غير قانوني.
سوريا في قلب لعبة الغاز
تُظهر تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية لعام 2025 أن حزام زاغروس ، الذي يشمل المياه الإقليمية السورية، يحتوي على 3.3 مليارات برميل من النفط و80.3 تريليون قدم مكعب من الغاز. ويزيد هذا من أهمية سوريا في موازين الغاز العالمية.
لكن أي اتفاق بين سوريا وتركيا على المنطقة الاقتصادية الخالصة قد يفتح الباب لتوترات دبلوماسية وعقوبات إضافية، خصوصًا إذا استُبعدت قبرص واليونان من المعادلة. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الدعم الدولي لإعادة الإعمار، رغم حاجة سوريا الماسة لمصادر دخل محلية.
وللإدارة السورية الجديدة مصالح تتجاوز الاقتصاد مع أنقرة، حيث كشفت مصادر مطلعة لموقع “Middle East Eye” أن تركيا بدأت استعدادات للتمركز في قاعدة “تياس” الجوية السورية (T4)، وتنوي نشر منظومات دفاع جوي هناك. وتتفاوض أنقرة ودمشق منذ سقوط الأسد على اتفاق دفاعي يشمل توفير الحماية الجوية من الجانب التركي.
ويهدف هذا الاتفاق الذي تخشاه إسرائيل، إلى تأمين الحكومة السورية الجديدة من أي تهديدات خارجية، مقابل تعاون استراتيجي في ملف الغاز. لكن هذه التفاهمات تضع الإدارة الجديدة في موقف حساس، بين الحليف التركي الطامح للهيمنة، والضغوط الغربية الرافضة لأي ترتيب يُضعف نفوذها أو مصالحها في المنطقة.
سوريا إذا، وجدت نفسها في قلب صراع مصالح لا علاقة مباشرة له بـ “تمثيل الأقليات” أو “العدالة الانتقالية” ـ رغم ضرورة هذه الملفات للعبور بسوريا إلى بر الأمان ـ، بل يرتبط بموقعها الجغرافي واحتياطاتها من الغاز. وبينما يُرحب الغرب بالحكومة الجديدة علنا، تبقى العقوبات قائمة وتخفف بالتدريج، لأن من يتحكم بالطاقة سيملك مفتاح السياسة.
—————————–
الشرع يعلن حكومة جديدة في سوريا.. تساؤلات حول قدرتها على تحقيق الاستقرار
30 مارس، 2025
مرصد مينا
في تحدٍ كبير للحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة السوريين وكسب ثقة المجتمع الدولي والدول الغربية، على أمل رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على البلاد، وفقاً لتحليلات سياسية متعددة.
ومساء السبت أعلن أحمد الشرع، الذي تولى رئاسة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر الماضي، عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي تتكون من 23 وزيراً دون تعيين رئيس وزراء.
وتم الإعلان عن هذه الحكومة بعد أسبوعين من إصدار إعلان دستوري مثير للجدل، منح الشرع صلاحيات واسعة لتشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مقربون من الشرع في المناصب الأساسية
تضم الحكومة الجديدة شخصيات مقربة من أحمد الشرع، حيث يشغل العديد من المناصب الأساسية المقربون من الفصائل المسلحة التي أطاحت بنظام الأسد.
من بين الشخصيات البارزة في الحكومة الجديدة أسعد الشيباني، الذي احتفظ بمنصبه وزيراً للخارجية، وكان قد التقى عدداً من المسؤولين الغربيين والإقليميين في فترات سابقة.
في حين بقيت حقيبة الدفاع مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري الذي كان له دور كبير في العمليات التي أطاحت بنظام الأسد، ويواجه الآن مهمة شاقة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.
أما أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، فقد تم تعيينه وزيراً للداخلية، وهو جهادي سابق كانت قد فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات.
بينما وزارة العدل فقد أُسندت إلى مظهر الويس، الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ في إدلب.
ويعتبر التشكيل الحكومي بمثابة انعكاس للتركيبة الديموغرافية للسكان السوريين، مع أغلبية سنية، بينما كانت البلاد سابقاً تحت حكم عائلة الأسد العلوية.
تعيين شخصيات من الأقليات
تعد هذه الحكومة مفاجئة من حيث تعيين شخصيات من الأقليات العلوية والمسيحية والكردية في مناصب حكومية، لكنهم حصلوا على حقائب وزارية ثانوية.
يُنظر إلى تعيين العلوي يعرُب بدر وزيراً للنقل والمسيحية هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، على أنه خطوة في محاولة لتوسيع قاعدة الدعم السياسي للحكومة الجديدة.
وفقاً للخبير السياسي فابريس بالانش، فإن تعيين يعرُب بدر، الذي كان قريباً من المسؤول الأممي عبد الله الدردري، يعد خطوة نحو تطمين الوكالات الأممية والولايات المتحدة.
بينما يرى الباحث في الشأن السوري في مركز “سانتشوري إنترناشونال” آرون لوند أن “الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين”.
ويعد الباحث أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل أشهر فقط.
ويشرح أنّ “وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلاً للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل”، مضيفاً “لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ”.
التحدي الكردي
أثار تشكيل الحكومة السورية الجديدة استياء من قبل الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت تجاهل الحكومة للتنوع السوري، مؤكدة أنها لن تنفذ أي قرارات تصدر عن هذه الحكومة.
وقد تم تعيين محمد تركو، كردي غير منبثق من الإدارة الذاتية، وزيراً للتعليم، ما أثار الشكوك حول مصير الاتفاقات السابقة بين الأكراد والسلطات السورية.
وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس الجاري إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبراً على ورق.
مخاوف من فشل الحكومة
يشير الباحثون إلى أن الحكومة الجديدة تواجه صعوبة في تحقيق الاستقرار في ظل الظروف الراهنة، خاصة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب الدموية التي شنها النظام المخلوع ضد معارضيه.
ويعتقد البعض أن الحكومة التي لا تضم رئيس وزراء قد تُنذر بـ”شخصنة مفرطة للسلطة”، ما يعرقل بناء استقرار سياسي.
وأكد فابريس بالانش أن الحكومة الفعلية قد تكون “مجلس الأمن القومي”، الذي أُسِّس في 13 مارس الجاري لمواجهة الصعوبات الكبرى، معتبراً أن هذه المجلس سيكون بمثابة “الحكومة الحقيقية”.
جدير بالذكر أنه مع التركيز على توحيد سوريا بعد سنوات من الانقسامات، يأمل الشرع وحكومته في جذب الدعم الدولي لرفع العقوبات، لكن هذه المهمة تبقى محفوفة بالتحديات الكبيرة.
—————————–
الاتحاد الأوروبي يرحّب بالحكومة السورية الجديدة وأميركا تضع شروطاً للتعاون
1 أبريل، 2025
رحّب الاتحاد الأوروبي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها لمساعدتها على مواجهة التحديات المقبلة.
وأصدرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، إلى جانب عدد من المفوضين الأوروبيين، بيانا يوم الأثنين جاء فيه: “الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لدعمها في التعامل مع التحديات الهائلة التي تواجهها.”
من جانبها، وصفت الولايات المتحدة تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “خطوة إيجابية”، لكنها شددت على أن العقوبات المفروضة على سوريا لن تُخفف إلا بعد تحقيق تقدم في الأولويات الأساسية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي مساء الأثنين:”ندرك معاناة الشعب السوري الذي عاش عقوداً من الحكم الاستبدادي والقمع، ونأمل أن يمثل هذا التشكيل خطوة نحو سوريا أكثر شمولاً وتمثيلاً لكافة فئات المجتمع.”
يُذكر أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أعلن يوم السبت الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 23 وزيراً، دون تعيين رئيس للوزراء.
————————–
الأمم المتحدة ترحب بإعلان الحكومة السورية الجديدة في سوريا
2025.04.02
رحب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالإعلان عن حكومة جديدة وموسعة في سوريا، مؤكداً على أهمية الانتقال السياسي الشامل الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.
وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال دوجاريك إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أكد على “أهمية الانتقال السياسي الشامل الذي يُمكّن الشعب السوري من استعادة سيادته، والتغلب على الصراع الدائر، وتحقيق تطلعاته المشروعة، بالإضافة إلى المساهمة في الاستقرار الإقليمي”.
وأضاف أن بيدرسن “يشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطات تصريف الأعمال نحو انتقال موثوق وشامل ومستدام، من حيث الحوكمة، وكذلك من حيث الخطوات الانتقالية التالية”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن ذلك “يشمل تشكيل مجلس تشريعي مؤقت ولجنة لصياغة الدستور، بالإضافة إلى الاستعدادات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لأعلى المعايير الدولية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي يعتزم زيارة دمشق قريباً، لمواصلة اتصالاته مع سلطات تصريف الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من السوريين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في سوريا.
حكومة سورية جديدة وترحيب عربي ودولي واسع
ومساء السبت الماضي، جرى في قصر الشعب بالعاصمة دمشق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيراً، بينهم سيدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية، التي تشكلت في 10 كانون الأول 2024، لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وقوبل إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة بترحيب واسع على المستويين العربي والدولي، حيث أعربت عدة دول ومنظمات عن دعمها للتشكيلة الجديدة، مؤكدة أهمية الاستجابة لتطلعات الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات التي أبدت دعمها، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس حرص المجتمع الدولي على دعم جهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.
————————-
الشيباني: الدعم الدولي للحكومة الجديدة يعزز الآمال برفع العقوبات عن سوريا
2025.04.02
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، إن تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة يعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة عن البلاد.
وأضاف الشيباني في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): “مع تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة، تتعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الشراكات السياسية”.
مع تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة، تتعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الشراكات السياسية. pic.twitter.com/r1QpMRMV7T
— أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani)
April 1, 2025
ترحيب بالحكومة السورية الجديدة
تأتي تصريحات وزير الخارجية السوري عقب ترحيب دولي من عدد من الدول العربية والغربية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة يوم السبت الماضي، إذ أعلنت دول قطر والكويت والإمارات وفلسطين ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة، ودعمها لسوريا. كما رحّبت دول إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم السلطات السورية في تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل، يحفظ التعددية وحقوق السوريين جميعا، ويعيد لسوريا وحدتها وسيادتها.
من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى جانب عدد من المفوّضين الأوروبيين، إنّ “الاتحاد الأوروبي مستعدّ للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها”.
——————————
===================