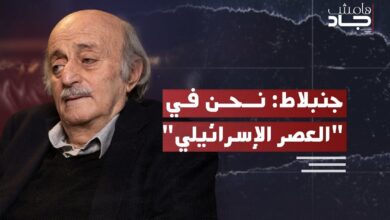حوار مع الفنانة السورية واحة الراهب:المنفى ليس مجرد فضاء نوستالجي

نهى السويد
02-04-2025
زيارة في الاستديو هي سلسلة من الحوارات مع شاغلين وشاغلات في الشأن الفني والأدبي والثقافي بأطيافه الواسعة، من سوريا والدول العربية والشتات العربي، يحتل فيها سؤال المكان أو مُختبَر عمل الفنان دوراً محورياً، إلى جانب الإضاءة على محاور أخرى من عمله وسيرته الفنية.
*****
فنانةٌ بوجوه متعددة، تنقّلت بين التمثيل والإخراج والكتابة والفن التشكيلي. أجادت التحولَ إلى ذاتياتٍ متعددةٍ في نطاقٍ تمثيلي واسع، انتقلت من خلاله إلى أدوارها المتنوّعة، وخلقتْ عبر شخوصها نوافذَ جديدةً للرؤية والفهم. تدير دَفَّتها بين الفنِّ والأدبِ، فتكتبُ بحبرِ الذاكرةِ والتجربةِ، وتتقن التنقيبَ في الشخصياتِ المعقّدةِ لتخلقَ منها عوالمَ خياليةً محكمةً، لكنَّها في الوقتِ ذاته تتنفسُ واقعيةً، أجادتْ صياغةَ الزمان والمكان لتدعمَ صناعةَ الحكايةِ بسردٍ قادرٍ على اختراقِ الوعيِ، يشدُّ القارئَ ويدفعه للتأمّل. صاحبة موهبةٍ ملفتة صنعتْ لنفسها تاريخاً فنيّاً بصمتهُ لا تخطِئُها عينٌ، التزمتْ قضايا مجتمعها في أدبها، انتصرتْ لذاتها وللكثيراتِ عندما فرضت موهبتها الإخراجية كأوّلِ امرأةٍ سوريةٍ تُخرجُ فيلماً روائياً طويلاً رغمَ كلِّ التحدّياتِ، في عالمٍ محكومٍ بالمعاييرِ لم تخشَ كسرَ القواعد لتصوغَ مسارها المتفرد، حيث شاركتْ في منتدياتِ ربيعِ دمشقَ متحدّية السلطةَ الأسديةَ قبلَ الثورةِ وبعدها، وعاشتْ المنفى بما أخذَ منها وأعطى. عن تبدُّل شكل ومواضيع الانشغال الفني مع الخروج من سوريا، وعن محطاتٍ فارقة في سيرتها الفنية، حاورنا الروائية والمخرجة السورية واحة الراهب في هذا الجزء من سلسلة زيارة في الاستديو.
في المنفى، اختبرَت أدواتكُ تغيُّراً. استعضتِ عن فضاء الصورة بالنّص المكتوب. هل كان اتجاهك للكتابة الروائية خياراً واعياً أملته ضرورة فنية داخلية، أم استجابة اضطرارية لقيود المنفى وتعثّر الإنتاج السينمائي؟
لقد كان التحوّل إلى الكتابة الروائية خياراً واعياً فرضته ضرورات الفن والمنفى معاً. فبعد استبعادي القسري من المشهد الدرامي ومنعي من العمل في التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو بسبب موقفي المعارض، وجدتُ في الرّواية فضاءً للتعبير الحرّ، لكن موضوع روايتي مذكرات روحٍ منحوسة سبقَ المنفى، إذ حال القمع الرّقابي دونَ تحقيقه قبل الثورة. ومع ذلك، لا أراه انحرافاً عن البوصلة الإبداعية، فالفنون متداخلة ومتكاملة، لا سيما في الإخراج، حيث تقتضي إدارة الكاميرا فهم السيناريو، وتحويل الفكرة إلى صورة نابضة بالمعنى. كما أنّ الإخراج يتطلب استبطان الشخصيات، وإدارة الممثلين، وتنسيق الإضاءة والديكور والأزياء بما يعكس روح العصر. كذلك، يرتبط إيقاع الصورة بإيقاع السّرد والتصعيد الدّرامي، تماماً كما هو الحال في الرّواية، حيث تتشكل العوالم الداخلية والخارجية بتناغم دقيق. وهكذا، يظلّ كلٌّ من الإخراج والكتابة فعلاً إبداعياً يُعيد تشكيل الواقع بصدق وجمال.
كيف تجلّى تأثير المنفى في رؤيتك السرديّة، مقارنة بسلطة الصورة التي كنتِ تألفينها؟ وهل منحتكِ الكتابة حريةً أرحب مما أتاحتْه لكِ السينما؟
للمنافي أثر الفراشات، تحلّق بعيداً عن قبضة الرقابة فتمنحُ الكلمة قدرتها على الانعتاق. ما كتبته في رواياتي لم يكن ليبصر النور في الداخل إلا مشوّهاً، ولو كنتُ هناك، لما أُتيح لي حتّى استكماله أمام بطش نظامٍ يستبيح حياة شعبٍ بأسره، وما زلتُ رغم المنفى هدفاً لمقصلة القمع. الإبداع الروائي لا يزدهر إلّا في فضاء الحرّية، إذ يتكئ على سحر اللغة وحدها، خلافاً للسينما التي تنبني على تضافر فنون عدة من تمثيل وتصوير وديكور وموسيقى، فعندما يصطدم الفيلم بالقيود أو القمع، يصبح من الضروري أن تستخدم الصورة تقنيات الاحتيال البصرية مثل التشفير والإيماء، لتوصل الرسالة دون أن تكشف عنها بشكل مباشر.
منحتني الرواية تعويضاً عن فضاء الصورة، إذ يحرّرها السّرد من إطار الكادر، ليطلقَ مخيّلة القارئ إلى فضاءات تتجاوز ما تتيحه العدسة. وهذا ما يجعل اقتباس الروايات إلى الشاشة، رغم أهميته، أقلّ قدرة على مجاراة اتساع النص الأدبي، الذي يظلّ فضاءً بلا سقف، تتعدد فيه التأويلات بتعدد القرّاء.
كيف انعكس تغيّر المكان والظرف على نتاجكِ الإبداعي، هل منحكِ المنفى أفقاً أرحب للإبداع، أم فرض على خيالك سرداً محكوماً بهاجس الفقد والتشرّد؟
خشيتُ أن ينضبَ معين السرد مع تبدّل المكان، إذ كان وطني منبتي، والمصدر الذي استقيت منه أحداث رواياتي. لكنّ ذاكرتي التي ازدحمت بصورٍ عشتها، والتصاقي بتطورات بلدي، وهاجسي الدائم بعكس هموم من أنتمي إليهم وجدانياً وفكرياً، جعلت خيالي لا ينضب مهما ابتعدت. بل إنّ البعد أتاح لي رؤية أكثر شمولاً، وفقاً لمقولة: «ابتعد قليلاً لأراك أوضح». لم يكن الفقد والتشرّد هاجساً يقيّد سردي، إذ لم تكن رواياتي ذاتيّة، بل عكست تناقضات شخصياتٍ تنتمي إلى فضاءات أرحب، تحمل هواجسَها المستقلّة. لذا، جاء كلُّ عملٍ مختلفاً، متعدّدَ العوالم، لا يُشبِه سواه.
عندما يغيّر الكاتب مكانه، يُعاد تشكيل رؤيته للعالم، لكن هل يمتد هذا التغيير ليصل صوته الداخلي ويُعاد تشكيله أيضاً؟ كيف تفاعل المنفى مع لغتكِ السردية، هل كان فضاءً لاستعادة سوريا بحنين الكتابة، أم مساحةً تحررتِ فيها من ثقلها؟ أدب المنافي كثيراً ما يكون غارقاً في النوستالجيا، هل ترين أن النوستالجيا خطر على الإبداع؟
المنفى يُغني العالم الداخلي للكاتب، ويُعيد تشكيل رؤيته وفضاءه السردي بحرّية لا تتيحها قيود القمع والرقابة. لقد حرّرني من ثقل البطش، إذ لم يكن مجرّد فضاء نوستالجي، وإنّما مساحة أعمق وأوسع لإعادة قراءة سوريا بعيداً عن محدودية الجغرافيا. فحنيني دفعني بقوّة لاستعادة سوريا بوعيٍ أوسع دون أن أغرق في الماضي، حيث تداخلت الواقعية بالحلم والتأمّل المعرفي. النوستالجيا شكلٌ من أشكال التعبير المشروع، لكنّها تصبح خطراً حين تحاصر الأدب في اجترار الآلام، فتحدّ من تطوره وتنوّعه، وتجرّده من بعده الإبداعي الأرحب في مقاربة الحياة والإنسان. المنفى يثري صوت الروائي، مانحاً إيّاه رؤية أكثر اتساعاً وعمقاً لفضائه السرديّ، وقد حررني من وطأة الرقابة القمعية، غير أنّ منحته ليست مجّانيّة، إذ ما كنت سأحظى بهذه الحرية لو لم تكن أفكاري وضميري أصلاً متحررين، ولو لم أكسر حاجز الخوف حتّى قبل مغادرتي سوريا. الإبداع يُعيد تشكيل العالم بعملية جدليّة، متجاوزاً حدود المكان. النوستالجيا، وإن كانت دافعاً لاستعادة سوريا عبر الكتابة، لم تحصر رواياتي في اجترار الحنين، بل دفعتها إلى تأمّل واقعها ومصيرها برؤية أوسع. إنّ الأدب الذي يختزل نفسه في النوستالجيا يفقد جوهره الإبداعي في التكرار الممجوج المتمحور حول الذات واجترار آلام الحنين، وعدم التطوّر والتنوّع في رؤية أوجه الحياة الغنية باختلافاتها ورؤاها.
التمثيل هو أن تسكني شخصيات الآخرين، بينما الكتابة الروائية هي أن تخلقي شخصياتكِ الخاصة. كيف كان الانتقال من أن تكوني مرآة لنصوص الآخرين إلى أن تصنعي عوالمكِ السردية بنفسكِ؟ وهل شعرتِ أن التمثيل كان مقدّمة ضرورية لفهم أعمق للإنسان، أم أنَّ الكتابة منحتكِ حرية التعبير التي لم يمنحها لكِ التمثيل؟ ماذا قدمت لك الكتابة؟
في التمثيل، كنت أُركز على خلق عالم كامل ومدروس لكلّ شخصية أؤديها، من خلال تفصيل جوانبها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية…، لأُغني عالمها الداخلي غير المكتوب بما ينسجم ولا يتعارض مع ما أقرأه بين السطور، هذا التميّز والشغف في تجسيد الأدوار المركّبة ساعدني لاحقاً في خلق شخصيات روائية غنية ومعقدة. الكتابة منحتني حرية أكبر لتطوير هذه الشخصيات بعيداً عن قيود النصوص الجاهزة، ما أتاح لي الغوص في أعماقها. كما أن تجربتي في الإخراج والتمثيل أغنت قدرتي على تقمّص شخصياتي الروائية وشحنها بعمق المشاعر الوجدانية المؤثرة. الكتابة والتمثيل يكملان بعضهما بعضاً، فالإخراج علّمني كيفية اختزال الكلام إلى صور معبّرة، والكتابة أكسبتني القدرة على إطلاق العوالم الداخلية للشخصيات. في النهاية، أكتفي بإدارة التناغم بين تطوّر الشخصية وتطوّر الأحداث من حولها.
إذا أغمضت عينيك تسترجعين ذكرياتك كممثلة، ما الذي ترينه؟ بماذا كنت تحلمين وهل حققت أحلامك؟
ذكرياتي في التمثيل كثيرة، لكن دوري في مسلسل جواهر يبقى علامةً فارقةً. جسَّدتُ شخصية «زوينة»، المرأة التي تعاني من الفصام، وأتذكر أنَّ أحد الممثلين الإماراتيين عرض مشاهد من المسلسل على وليِّ العهد، مموِّل العمل آنذاك. فجاء قراره قاطعاً: «اكتبوا الجزء الثاني فوراً، ولا مجالَ لاعتذار واحة الراهب». وحين حاولتُ الاعتذار عن الجزأين الثاني والثالث، قيل لي: «إذا انسحبتِ، توقف العمل».
كان التصفيق يملأ موقع التصوير بعد انتهاء تصوير مشاهدي، خاصة في الجزء الثاني، فتجسيدُ مرض الفصام كان تحدياً مرهقاً. لم أؤدِّ الدور كما كُتب فحسب، بل أعدتُ خلق الشخصية عبر دراسةٍ معمَّقةٍ للمرض، فأضفتُ إليها ما لم يكن في النص، محوِّلةً العناوين العريضة إلى تفاصيل نفسية متجذِّرة.
في القصاص، أخرجه زوجي مأمون البني، كنتُ أمام واحدٍ من أكثر المشاهد انفعالاً. المطلوب أن أبكي من الداخل، بكاءً يعتصر الروح ولا يفضحه الوجه. غرقتُ في الحالة حدَّ الرعب، فصرخ مأمون وأوقف التصوير: «ستؤذين نفسكِ، يكفي!»، كانوا يخشون أن أصابَ بجلطة، بينما كنتُ أشعر بالقهر، لأنهم انتزعوا مني لحظةً كنت مستعدةً لدفع حياتي ثمناً لها. مثلُ هذه اللحظات لا تُعاد، فالشعور لا يتكرر بالعمق نفسه، والمشهد الحقيقي لا يُستنسخ بالتكنيك وحده. بعد هذا النوع من المشاهد، كان ضغطي يهبط بشدة، فيسارعون بجلب القهوة والمخلل حتى أستعيد توازني.
أمّا أحلامي، فلم يتحقق إلا النزر اليسير ممّا أطمح لتقديمه إلى المشاهدين والقرّاء، لا كممثلة، ولا كمخرجة، ولا كروائية. قبل الثورة بعشر سنوات، كنت أواجه حرباً مستمرة، وسيناريوهاتي الجاهزة دُفنت بقراراتٍ سياسيةٍ تفرض على شركات الإنتاج أسماءً بعينها وتقصي أخرى. وكامرأةٍ، كانت الحرب مضاعفةً؛ فقد اقتحمتُ الإخراج في وسطٍ يسيطر عليه الرجال. ورغم كلّ شيء، لا تزال رغبتي في العودة إلى التمثيل مشتعلةً، فهو الفن الذي أعشق. صحيحٌ أنَّ الإخراج والكتابة يمنحانني سلطةَ التعبير عن أفكاري بعمق، كوني صاحبة المشروع، بينما يضعني التمثيل داخل أدوارٍ كتبها غيري، لكنني لا أقبل أن أكون مجرد أداةٍ، ولا أن أؤدي شخصيةً تزيّف وعي الجمهور، بل أسعى دائماً إلى أن أترك بصمتي الخاصة عليها. أعشق التمثيل لأنه يربطني بالناس، يتيح لي أن أعيش معاناتهم، وأن أكون مرآةً لآلامهم وأحلامهم. فالممثل الحقيقي ليس من يحفظ النصوص، بل من يتلبَّس أرواح الآخرين ويجسدها بصدقٍ لا يعرف الزيف.
في كتابكِ «صورة المرأة في السينما السورية» الصادر 2001، كنتِ من أوائل من كشفوا عن اختزال حضور المرأة في أنماط جاهزة على الشاشة. بعد ما يزيد عن عقدين من الزمن، كيف ترين صورتها الآن؟ هل تَظنّين أن الثورة السورية قد أسهمت فعلاً في تفكيك الصورة التقليدية للمرأة السورية في السينما والدراما، لتفتح أمامها أفقاً جديداً يعكس التحولات الجذرية في الواقع الاجتماعي والسياسي؟ أم أنها ما تزال أسيرة للكليشيهات القديمة التي تُعيد إنتاج تمثيلها وفقاً لنماذج قديمة لا تتماشى مع معاناة الواقع وتشظياته؟
إنَّ قضية المرأة في السّينما السورية آنذاك مغيّبة تماماً، باستثناء تزييف الواقع الذي قدّمه الاتحاد النسائي الموالي للسلطة. لكنّني لم أقتصر على تقديم صورتها من خلال النظرة الإصلاحية التقليدية، بل خصصت فصلاً للاتجاه النقدي التغييري، الذي اقترب من تصويرها بواقعية بعيدة عن تنميطها الذكوري، وتحديد مكانتها وإمكانيّاتها بلعب دور الأمٍّ البريئة البعيدة عن الشبهات، أو سلعة منحرفة، أو الشخصية الواقفة خلف الرجل في تقدّمه، وليس بجانبه. حاولتُ تصويرها في بعد إنساني أعمق، يمنحها إمكانيات وأحلاماً تتجاوز الأطر التي حددتها النظريات الإيديولوجية السائدة، لتتّسق مع رؤية واقعية ترى في تحررها جزءاً من تحرير المجتمع واستقلال البلاد.
أما في واقعنا اليوم، فقد أضاءت صورة المرأة السّورية في ثنايا الثورة، بعد أن انطلقت بمشاركة نضالية مكافئة للرجل، قدّمت خلالها التضحيات الغالية وقادت التغيير في واقعها المأزوم. ورغم هذا التحوّل الجذري في دورها، فإنّ السّينما والدراما السّورية لم تواكب هذه التحوّلات بما يليق بها، إذ بقيت صورة المرأة محصورة ومكبّلة، حتّى في الأعمال التي تناولت الثورة بجرأة، حيث ظلّ دورها في كثير من الأحيان في الظلِّ، محدودَ التأثير، ضئيلَ الفاعلية. يعود هذا إلى الهيمنة الإعلامية للنظام وما رافقها من سياسات مشوّهة تهدف إلى تشويه صورة الثورة، ووصمَها بالتطرّف والإرهاب، ما ألقى بظلاله على الأعمال الفنية، وجعلها تفقد مصداقيتها تحت وطأة الرقابة المشددة. ومع تغييب الحقائق واحتكار السّرديات وفقاً لرؤية النظام، تمَّ استبعاد دور المرأة الفاعل في الثورة، مما دفع بكثير من الأعمال الفنية إلى التوجّه نحو المواضيع البيئيّة والتاريخيّة، أو حتّى تعريب الأعمال التركيّة، هروباً من القيود السياسيّة التي سلبت الفن عمقه ومصداقيته.
في روايتك «حاجز لكفن» تقدمين لنا صورة متشابكة ومعقّدة عن المرأة السورية التي تعيش بين فكيّ آلةٍ قمعيّة لا ترحم، في ظلّ حربٍ مريرة ومجتمعٍ مُشْبع بالذّكوريّة والانغلاق. هل تعتقدين أنّ هذه الصورة التي قدمتها للمرأة السورية يُمكن أن تفتح أفقاً جديداً لفهم الصراع الداخلي الذي تعيشه؟
روايتي حاجز لكفن هي التعبير الحقيقي عن هذا التشابك الفعلي المعقد بين واقع المرأة المقموع في كافة جوانب حياتها، وبين النظام القمعي الذي يعمّ الجميع، وهذا ما يُعرّض المرأة لقمعٍ مُزدوج، الأوّل من النظام نفسه، والثاني من الرجل شريكها في الحياة والمجتمع المقموع. الرّواية تُسلط الضوءَ على الصّراع الداخلي الذي تعيشه المرأة نتيجة هذا التداخل بين القمع الداخلي والخارجي، مما يجعلها جزءاً من حلقة مُغلقة تُعزّز المعاناة. كما أشار النقاد إلى أنَّ الرّواية تعبّر عن معاناة النساء في كافة الأقطار العربية، متناولةً قضاياهن الاجتماعية والسياسية والثقافية. الناقد فهد حسين وصف الرواية بقدرتها على مزج الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي بالمتخيّل، حيث تناولت في 127 صفحة معاناة النساء عبر مختلف الأقطار العربية، باختلاف درجاتها، وفق حقوقهن، ومواقعهن الاجتماعية والمهنية، بينما اعتبر سلمان زين الدين أن الرواية تُفكك آليات القمع في الأسرة والمجتمع والدولة، وهي آلياتٌ كثيراً ما يتمُّ فيها تبادل الأدوار، فالأوسط هو جلاّد الأدنى وضحية الأعلى في متوالية قمعية. ورأت آراءٌ قيّمة أنَّ حاجزٌ لكفن نكأًت الجرح الخاص بالمرأة، ونكأت جراح المجتمع المحلي والعربي عموماً، من خلال ربط وثيق لا يمكن فصله بين تشابك قضايا المرأة ومصيرها وبين مصير الوطن بأسره، بالقدر نفسه من التعقيد الذي يجعل من المستحيل تحرر مجتمع دون تحرر المرأة التي تشكل نصفه، بل وتغدو هي الغالبية والمربيّة بسبب الحروب. إن لم تكن حرّة، فلن يتحرّر المجتمع أبداً، إذ ستُعيد إنتاج الاستبداد، وتكرّس متوالية العبد والسيد والخوف عبر تنشئة أبنائها، ذكوراً وإناثاً، على ما نشأت عليه وتربّت في ظله.
في كل من «حاجز لكفن» و«مذكّرات روح منحوسة» و«الجنون طليقاً»، تتحركين في فلك المعاناة السورية بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والسياسية، من خلال شخصيات تتماهى مع الواقع المأساوي، فتسبرين أغوار الداخل السوري بألم وجنون وحيرة. في ظلّ هذا الإصرار على الغوص في عمق الجرح السّوري، هل ترين أنّ الأدب في هذا السّياق هو حقّاً مجال تعبيريّ خاص، يتجاوز توثيق الواقع إلى محاولة خلق مساحات للتحرر من خلال الخيال، أم أنَّ الواقع السّوري بمظاهره القاتمة قد فرض نفسه على الكتابة بحيث يصبح الكاتب، عن غير قصد، أسير همومه الوطنية؟ وفي هذا السياق، هل تعتقدين أنّ هذا الهم الوطني يشكل عبئاً على الكاتب، أم أنَّه يصبح في لحظة من اللحظات الوسيلة الوحيدة التي تنقله من أسر الواقع إلى فضاء الأدب اللامحدود؟
لا شكّ أنَّ الواقع السوري المأساوي يطبع ذاته على الأدب، إلا أنّ الإبداع الأدبي لا يظلُّ محصوراً في نقل الوقائع كما هي، بل ينطوي على تحرير الواقع من أسره نحو آفاق أرحب تتنقل من التوثيق إلى الخيال الذي يعيد تشكيله. الأدب الصادق لا يقتصر على مجرد تصوير الوقائع، بل هو صياغة جديدة للأحداث والشخصيات التي قد تتجاوز حدود الممكن نحو الغرابة والسريالية. لذلك، حتّى في استعانتي بالواقع، لا أقدمه بحرفيّته، بل أعيد تشكيله بما يتلاءم مع مسارات شخصياتي ومصائرها التي أراها تنبثق من خيالي، قد تمرّ هذه الشخصيات بتمرّد ربّما يُفرِغُها من الجوانب التي أسندتُها إليها. ولذا، لا تعتبر رواياتي سيرة ذاتية، بل هي أبعاد تتشكل من الواقع لتنسج عوالم غير واقعية، لكنها تنبض بمصداقية تستند إلى جذرها الصلب. ففي مذكرات روح منحوسة والجنون طليقاً، رغم أنني استلهمت بعض عناصر الواقع السوري، انطلقتُ في خلق عوالم مغايرة، حيث لا أبحث عن تصوير واقع مرير، بل عن خلق واقع جديد يُمكِّن الأدب من الخروج من حدود الزمان والمكان.
بالنظر إلى وضع النساء السوريات في الوقت الراهن، كيف تقيّمين مسارهنّ في ظل الواقع السياسي والاجتماعي المتأزّم؟ هل هناك أمل حقيقي في تحقيق تقدّم في حقوقهن، أم أنَّ الظروف القاهرة التي تمرُّ بها البلاد تعيدهنّ إلى دوامة من التهميش والحرمان؟ وهل تحملين مخاوف بشأن المستقبل، وما هي رؤيتكِ لما قد يترتب على الوضع الراهن؟
لقد شكّلت نساؤنا نصف هذا المجتمع الذي ثار ضدَّ أقسى الأنظمة وتمكنّ من إسقاطه، وهنّ الأكثر وعياً بمصلحتهنّ من خلال معاناتهن المضاعفة. فقد كنّ الغالبية التي تحمّلت إعادة بناء العائلات المدمرة بعد غياب العديد من الرجال بفعل الحرب. إلا أنَّ مصيرهن سيظلُّ مرهوناً بالنظام السياسي القادم وقوانينه، لذا لا يمكنهن الرجوع إلى الوراء بعد كلّ ما أنجزنه من تقدّم. الأهم هو تغيير العقلية الذكورية المتخلّفة الّتي ساهمت في تخلّفنا، ولن تقف النساء اللواتي تحمّلن هذه المسؤوليات صامتات أمام أيّ ظلمٍ يمسُّ حقوقهن، لذا يبقى الأمل قائماً ما لم نسمح بثورة مضادة تلتف على مطالبنا الحقيقية، ومنها تحرير المرأة والرجل لبناء مجتمع حر وديمقراطي. تحقيق هذا التحرر لا يتم دون انتشال المرأة من التهميش والحرمان، وتضافر جهودها مع الرجل وبقية مكونات المجتمع.
كيف ترين سوريا المستقبل، في ضوء ما شهدته البلاد من تحولات مؤلمة؟ هل تعتقدين أنّ بإمكان الأدب والفن إعادة بناء سوريا ذات الهوية الجامعة، أم أنّ النسيج الاجتماعي قد تمزق بحيث لا يمكن ترميمه؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الكتابة في إعادة إحياء ذلك الحلم السوري المشترك؟
تحرُّرنا من النظام المافيوي تحقّقَ، لكن الانتصار على إرثه الفاسد، وترسيخ قيم الثورة من حرية وعدالة ومواطنة لم يتحقق، فوعود التغيير مبشّرة، لكنها لم تترسخ كدعائم دستورية وقانونيّة تحميها. وهنا يبرز دور النخب المثقفة والإبداعية في صون هذا التحرير الوليد من الانتكاس، فقول الحقيقة والنقد البناء كانا دوماً منارة نهضة الأمم وتطورها.
رغم محاولات النظام تمزيق نسيجنا الاجتماعي، ظل رهاني على وعي شعبنا ثابتاً، وقد أثبتت الثورة ذلك بإسقاط أكبر طغمة استبدادية عرفها تاريخنا الحديث. فرغم المجازر والتشريد، أظهر الثوار تسامحاً يؤكد أن هذا الشعب، الذي هزم نظاماً استجلب جيوش خمس دول عظمى وميليشيات طائفية، لن يسمح بطمس هويته أو قضيته. وكما توحدت البلاد بعد الاستقلال، لدينا اليوم فرصة تاريخية لتجاوز الحصار الخارجي والفتن الداخلية التي يزرعها فلول النظام. دور الأدب والفن جوهري في إعادة تشكيل الوعي الجمعي وإحياء الحلم السوري المشترك، لكنه لن يزدهر دون رفع مستوى التعليم والقدرة الشرائية، أو تحويل الإبداع إلى أعمال درامية تصل حتّى للأميين الذين ازدادت أعدادهم بسبب الحرب. فالأدب والفن ليسا ترفيهاً مجرداً، بل مقياساً لنهضة الشعوب وهويتها الحضارية.
كانت الثقافة في سوريا الصوت البديل عن خذلان العسكر حتى الثمانينيات، لكن تغوّل النظام حطمها بتكميم الأفواه والسيطرة على كلّ المنابر الفكرية والفنية. ومع انحياز المبدعين لثورات الربيع العربي، أدرك النظام خطورة تأثيرهم، فعزز قبضته على الإعلام والثقافة. واليوم، يبقى تحرير الأصوات الإبداعية وإطلاق طاقاتها ضرورة ملحّة لمواصلة الثورة وترسيخ قيمها.
لو كُتب تاريخ سوريا الحديث يوماً بإنصاف، وتمّ تناول الفن والأدب والسياسة كعناصر متشابكة في تشكيل الوعي، كيف تودّين أن يتمّ ذكركِ؟ كمخرجة، أم كممثلة، أم كروائية، أم كصوت معارض قاوم عبر الكلمة والصورة؟
الفن عندي كلٌّ لا يتجزأ، فمن خلاله أوصلت صوتي كمعارضة معنية بقضايا شعبها. في التمثيل لم أكتفِ بتجسيد الشخصيات، بل نقلتُ عمقها الداخلي في انسجام مع الواقع، وفي الإخراج صغت رسائل بصرية وسمعية تصل بوعي ومتعة وعمق. أما الرّواية، فكانت فضائي الأرحب، حيث الحكايات تجسّد الواقع دون نفاق الخطاب السياسي. الفن والأدب يظلان محميين بمصداقيّتهما، وسقوطها يعني هلاكهما. أمّا الإعلام، فكان منبري المباشر لفضح النظام، وشدّ أواصر الثورة، والحفاظ على البوصلة. هكذا تكاملت أدواتي، كلٌّ يكمل الآخر، ليحمل صوتي بصدق وثبات.
لو أتيحت لك فرصة إخراج حياتك كفيلم سينمائي، عند أي مشهد في رحلتك تتوقفين وتتمنين تقديمه بشكل أفضل؟
لو أخرجتُ حياتي كفيلم، لتوقفتُ عند معركة فيلمي رؤى حالمة، حيث اصطدمتُ بأنظمة القمع، داخلياً وعالمياً. فيلمي، كأول عمل روائي طويل تخرجه امرأة في سوريا، كشف قهراً مزدوجاً: ذكورية متجذرة تدّعي التحرر، واجتياحاً خارجياً يعكس الاستبداد الداخلي. سبع سنوات من التعجيز، ثم عامان من الإقصاء، حتى قادت المواجهة الإعلامية التي قمت بها إلى إسقاط مدير المؤسسة وإنصاف الفيلم، رغم اعتراض «مخرجين تقدّميين» كانوا بالأمس داعمين.
في مهرجان دمشق 2003، مُنع الفيلم من الجوائز بتوجيهات أميركية للنظام السوري، الذي كان مهدّداً من قبلها بعد غزو العراق، أملت عليه شروطها، وجزء منها عدم التطرق سياسياً أو ثقافياً وإعلامياً لأي صراع مع إسرائيل، أو لأي طرح للوحدة والقضايا العربية المشتركة، والأمران مضمّنان في فيلمي هذا، حتّى تمويل الخارجية الفرنسية التي وافقت على السيناريو، وأشادت في رسالتها بأهميّة خلقي للتوازي بين العدوين الخارجي والداخلي المتجسد بسلطويّة الأب، قُدِّم مشروطاً بحذف الاجتياح الإسرائيلي للبنان، فرفضتُه، ما أدى لاحقاً إلى رفض سيناريو آخر قدّمته لهم. كان هذا الفيلم تجسيداً لحقيقتنا الموجعة: أنظمة تكمّم الداخل، وقوى تفرض سرديّاتها، وأوطانٌ تُهزم ما دام الإنسان غيرَ حرٍّ.
موقع الجمهورية