السلم الأهلي الهشّ: جمر الثنائيات السورية تطفئه 6 مبادئ/ زيدون الزعبي
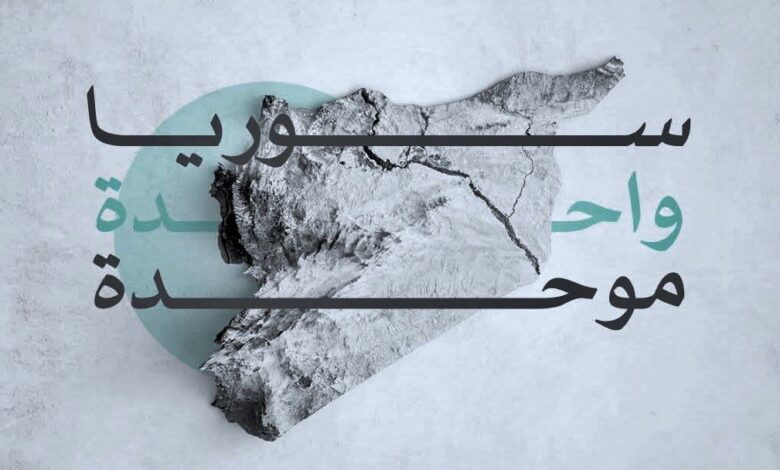
08 ابريل 2025
بدت مطالبات بالسلم الأهلي عديدة غير جديّة، إن لم نقل ساذجة وغير عقلانية، فمن مطالباتٍ بعفوٍ عام إلى حلّ الأمر على قاعدة “تبويس الشوارب”، إلى أخرى دعت إلى تحقيق السلم عبر المحاسبة المباشرة، وبأن أي مطالبةٍ لتطبيق القانون ومسار العدالة الانتقالية ليس إلا مثالية زائفة لا معنى لها، خصوصاً في ظل تأخّر الدولة الناشئة في طرح مسارات عدالة جدّية.
تبدو قضية السلم الأهلي واحدة من أكبر مهدّدات الدولة السورية وهي تولد من جديد، فالاستقطاب الهائل بين الثنائيات السورية الحاضرة بقوة، قبل انتصار الثورة وبعده، يجعل السلم الأهلي، والاطمئنان الذي أشاعه شكل الانتصار، وبالحد الأدنى من الخسائر في الأرواح، في مهبّ الريح. فثنائية أكثرية – أقلية، التي تأخذ أشكالاً مختلفة بين سُنّة وعلويين، وكرد وعرب، وعلماني ومحافظ، ومعارض للنظام السابق ومؤيد له، تُنذر باقتتالٍ لا يبقي ولا يذر.
ومع وجود حوامل إقليمية ومحلية تسعى إلى إشعال الصراع وتسعيره، سواء بالتحريض الطائفي والمذهبي والقومي، أو حتى بالتسليح والتمويل، يصبح السلم الأهلي في غاية الهشاشة، وتكاد حربٌ طائفيةٌ تندلع مهما حاول منعها حماة السلم من دولة ومجتمع مدني وأهلي.
من زاوية أخرى، بدت مطالبات بالسلم الأهلي عديدة غير جديّة، إن لم نقل ساذجة وغير عقلانية، فمن مطالباتٍ بعفوٍ عام إلى حل الأمر على قاعدة “تبويس الشوارب”، إلى أخرى دعت إلى تحقيق السلم عبر المحاسبة المباشرة، وبأن أي مطالبةٍ لتطبيق القانون ومسار العدالة الانتقالية ليس إلا مثالية زائفة لا معنى لها، خصوصاً في ظل تأخّر الدولة الناشئة في طرح مسارات عدالة جدّية. وعليه، يبدو من الواجب اليوم وضع مبادئ أولى للسلم الأهلي، لا لتكون مبادئ نهائية، بل لتكون وثيقةً حيّةً منفتحةً على المقترحات والتطورات المحتملة للقضية السورية.
أولاً: انتصار شعب لا طائفة
يقول نيلسون مانديلا: “كرّست نفسي طوال حياتي لهذا النضال الذي يخوضُه الشعب الأفريقي. لقد ناضلتُ ضدّ هيمنة البيض، وناضلتُ ضد هيمنة السود. لقد اعتززتُ بمبدأ المجتمع الديمقراطي الحر الذي يعيش فيه كل الناس معاً في وئام وتكافؤ الفرص. إنه مبدأ أتمنّى أن أعيش من أجله وأن أحققه. وإذا لزم الأمر، هو مبدأ أستعد للموت من أجله”. من هنا، يمكن القول إن تأسيس قضية العدالة ربما كان كامناً في تحديد ماهية الصراع ونتائجه، فهل مَن انتصر هو فصيل أو فصائل المعارضة على جيش النظام؟ أم هو انتصار طائفةٍ على أخرى أو أخريات؟ أم هو انتصار الشعب المظلوم على نظام جائر ظالم؟ جواب هذا السؤال يكمن في توصيف ما جرى خلال السنوات الأربع عشرة المنصرمة، هل ما كان ثورةً أم حرباً أهلية؟ ربما كان التوصيف العلمي الأكاديمي حرباً أهلية، غير أنه، في ضمير غالبية السوريين، ثورة، ولا تسامح مع أي توصيفٍ له خارج هذا النطاق، فإذا كانت ثورة، فكيف تكون ثورة مكوّنٍ ما ضد مكوّنٍ ما، أو كيف يُلام على قمعها مكوّنٌ؟ وكيف يكون ضحيّتُها مكوّناً؟
تهدف الثورة إلى أن ينتصر الشعب على منظومة حكم سياسية، وعلى مجموعة القيم التي كانت تكرسها، وهذا ما تبنته شرائح واسعة من منتسبي الثورة! إذاً هي ثورة، وفي الثورة ينتصر الشعب، كلّ الشعب، لا جزء منه، ولا طائفة منه على جزء آخر أو طائفة أخرى. زد على ذلك، أن أحد أهداف الثورة السامية اقتلاع جملة ممارسات كانت السلطة البائدة تسعى إلى تكريسها، واحدة منها، وربما أهمها، هي الطائفية. إذ كانت السلطة البائدة تحاول وسم الثورة بأنها إرهاب، في تدليس وتضليل موصوف لربطها بالسُّنة، بمواجهة الأقليات، فيما جهدت الثورة في تثبيت أنها ثورة شعب، كل الشعب، ضد النظام، والنظام فحسب. بالتأكيد، سيقول قائل إن كل من هم في المخيمات، والغالبية الساحقة من المعتقلين، والمدن المدمرة هي مدن سُنّية وهذا صحيح، لكن هذا هو جوهر سردية السلطة التي حاولت تكريس الثورة بوصفها حراكاً لجزء من طائفة ضد طائفة، وبالتالي، يصبح انتصار الثورة، في أحد أهم أوجهه، انتصاراً على الطائفية بوصفها واحدة من أهم أدوات السلطة البائدة، لا تكريساً لها.
ثانياً: المواطنة بمواجهة خطاب الأكثرية – الأقلية
تبدو مصطلحات مثل الأكثرية والأقلية سائدة في خطاب النخب والعامة السورية، وبالتالي يظهر خطاب من قبيل حماية الأقليات في سرديات النخب السورية، بل حتى في خطاب “المجتمع الدولي” ليظهر الأقليات مجموعاتٍ قليلة ذليلة بمقابلة أكثرية دموية ذات أنياب تسعى لافتراس الأقلية، في حين أن قيم الثورة الأساسية تكمن في مفهوم المواطنة المتساوية، الذي يساوي بين المواطنين السوريين، بغضّ النظر عن الجنس والخلفية الإثنية. وما لم يسد خطاب المواطنة بين النخب، أولاً وعاشراً، فإن سردية انتصار جزء من الشعب على جزء آخر ستسود، ليصبح ما جرى حرباً أهلية، لا ثورة.
ثالثاً: منطق الدولة
ليس مفاجئاً القول إن النظام السوري البائد خلّف هيكل دولةٍ، ينخر الفساد والعقوبات مؤسساتها، فالقضاء فاسد ومترهّل ومثقل بقوانين بعضها بالٍ، وآخر ليس إلا سيفاً مسلّطاً على رقاب البلاد والعباد، ثم جاء قرار حلّ الجيش، الذي أصدره النظام البائد، وكرّسته السلطة الحالية، ليكون تكريساً لإنهاك الدولة. تبدو الدولة إذاً اليوم في حالة ضعفٍ شديد، وما لم تُدعَم الدولة فإن حرباً أهليةً وحرب الجميع ضد الجميع تنتظر البلاد، ومن دون أن تنصبّ الجهود اليوم على حماية الدولة ومنطقها، وبناء مؤسّساتها فإن السلم الأهلي في خطر داهم.
أول المعنيين بحماية منطق الدولة هو السلطة الحاكمة اليوم، فالمطلوبُ من السلطة الآن هو التحلّي بالحكمة اللازمة لحماية الدولة ذاتها، وتشميل القوى السياسية والاقتصادية كافة من دون أي إقصاء لأي تيار سياسي أو مكوّن اجتماعي، والإسراع في مسار العدالة الانتقالية، وإيجاد حلول منطقية لتضخم العمالة والبطالة المقنعة خارج إطار التسريح التعسفي، واجتراح حلول اقتصادية للفقر المستشري.
غير أن السلطة اليوم غير قادرة على مواجهة هذا الكم الهائل من التحدّيات، ما لم يتصدّ المجتمع المدني والأهلي لهذه المشكلات. بالتأكيد، سيقول قائل إن مساندة هذه السلطة تعني تمكينها، وربما تهيئة الظروف لاستبدادها في السلطة، وهذا صحيحٌ ومخاطرة لا بد منها، وإلا فإن انهيار هذه السلطة قد يعني انهيار هذه البلاد. عليه، على المجتمع المدني الاستمرار بالضغط لجهة تشميل منطق المواطنة وتعميمه، إلى جانب حماية منطق الدولة.
لا يكفي هذا بالطبع، إذ يبدو وجود السلاح خارج الدولة من أكبر مهدّدات الدولة الوليدة، ومن دون آليةٍ سلمية لضمّ الفصائل قائمة على أساس وحدة السلاح والتشميل في آن واحد، فلن تقوم للدولة قائمة.
رابعاً: حماية الوسط في مواجهة الاستقطاب
بالعودة إلى مانديلا الذي قال: “لا يولد أحد وهو يكره شخصاً آخر بسبب لون بشرته أو أصله أو دينه. يتعلّم الناس الكراهية، وإذا كان يمكنهم تعلّم الكراهية، فيمكنهم أن يتعلّموا الحب أيضاً”. … وعليه، نرى أنه ما إن انطلقت الثورة السورية، حتى ظهرت استقطاباتٌ كانت تختبئ خلف ستار الخوف والقمع، فثنائيات المدن الكبرى مقابل الصغرى، والريف مقابل المدينة، وغرب سورية مقابل شمالها الشرقي، وعربي مقابل كردي، فضلاً عن انتماءاتٍ طائفيةٍ ودينيةٍ عميقة، غير أنه بعد تسلح الثورة بفعل قمعها الجنوني من النظام البائد، لم تتعمّق هذه الاستقطابات فحسب، بل ظهرت استقطاباتٌ جديدة كثنائية داخل – خارج.
في زمن الاستقطاب يذوب الوسط، بكل معانيه، وبدل الحوار تخنق البلاد لغة التخوين والعداء وخطاب الكراهية. يختلف الطرفان المستقطبان في كل شيء إلا عداء الوسط، الذي بحكم وسطيّته يسارع إلى الانكفاء ليترك الساحة للعداء والكراهية.
ما لم يكن الوسط فاعلاً وقوياً ومنخرطاً مع طرفي الاستقطاب، بالحوار معهما، وبالتجسير فيما بينهما، لا بالتعالي عليهما، وبعضلات مفرودة وظاهرة، فإن الاستقطاب سيعني انقسام المجتمع عمودياً، وربما تقسيم البلاد.
خامساً: التشميل
“أريد أن تهبّ ثقافات جميع الأمم حول منزلي بحرية، ولكنني لا أريد أن تقتلعني إحداها من جذوري” قال المهاتما غاندي يوماً. إذاً، ما لم يظهر الفضاء العام تشميلياً، بالمعنى الحقيقي للتشميل، فإن أي خطاب سلمٍ أهليٍّ يصبح عبثاً وصيحة في وادٍ. بالتأكيد، لا يجب أن يأخذ التشميل شكله الاستعماري على أساسٍ إثنيٍّ لما يصبح محاصصةً طائفية، فالعراق ولبنان حاضران في ضمير السوريين مثالَين لتفسيرٍ استعماريٍّ لمعنى التشميل. يكفي أن يكون التشميل سياسياً وجغرافياً وتقنياً، ليضمن تمثيل الجميع من دون الولوج في وحل الطائفية والمحاصصة، ففيما لو كان التمثيل سياسياً بضمان وجود تشكيلاتٍ من الأحزاب، والقوى السياسية، و/أو كان جغرافياً على قاعدة تمثيل المناطق، و/أو على أساسٍ تقنيٍّ كأن تمثل النقابات المنتخبة ديموقراطياً، فإنها، في غالب الأحوال، ستضمن تمثيل جميع المكوّنات بنسب منطقية، تماثل وجودها المجتمعي.
غير أن التشميل يجب أن يكون ذا معنى، لا أن يكون شكلياً، أي أن تكون فئات الشعب حاضرة في عملية اتخاذ القرار، لا في عملية التصديق الشكلية عليه. وكل تشميل محمودٌ، على أن يكون جدياً وفاعلاً.
سادساً: العدالة
يقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): “إن الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا يُنزع من شيءٍ إلا شانه”، ويقول غاندي: “العين بالعين يعني مجتمعاً أعمى”.
لا يمكن لأي سلمٍ أهليٍّ أن يحدُث إلّا على قاعدة العدالة، فلا سلام من دون عدالة، عدالة لا تهدّد استقرار البلاد، ولا تقتصّ من طرفٍ على حساب آخر، فمن أمر ليس كمن نفّذ، ومن نفّذ ليس كمن هاجم بالكلام، ومن هاجم بالكلام ليس كمن صمت عن القتل، ومن صمت عن القتل ليس كمن كظم غيظَه، وسكت عن خوفٍ من الأسدية أو عن رغبة في البقاء في البلاد وعدم تركها لنظام الأسد ينهشها.
ورغم ذلك، لا يمكن لأي دولةٍ أن تحتمل معاقبة كل من أساء أو ارتكب ومن جميع الأطراف، وإلا سنشهد محاكماتٍ تقضّ مضجع البلاد برمتها، فالعدالة الانتقالية ليست إلّا جسراً بين ماضي سورية المثقل بالجراح، والمستقبل الحالم بالسلام والعدل. إنها ليست مجرّد قانون يُسنّ أو محكمة تُقام، بل هي نداءٌ إنسانيٌّ عميقٌ لاستعادة التوازن بين الذاكرة والنسيان، بين العقاب والمغفرة، بين الانتقام والمصالحة. تبدو العدالة الانتقالية اليوم بوابة الأمل الوحيدة، إذ لا يُطلب من الضحايا أن ينسوا، ولا من الجناة أن يختفوا، بل أن يعترفوا، أن يُواجهوا الحقيقة بقلوبٍ جريحة، وأن يجلسوا معاً في ساحة التاريخ ليعيدوا صياغته بعد أن شوهته سنوات القمع والدم.
ليست هذه المبادئ نهائية، ولا تفترض صحّتها النهائية، بل تطرح نفسها على طاولة الحوار بين الجميع ولصالح الجميع. أطرح هذه المبادئ لأقول: تعالوا إلى كلمة سواء، تنقلنا إلى مستقبل آمن.
العربي الجديد




