ملاحظات حول الموت والمعنى: في الحاجة إلى لغة تسمح لنا بالإمساك بحياتنا/ موريس عايق
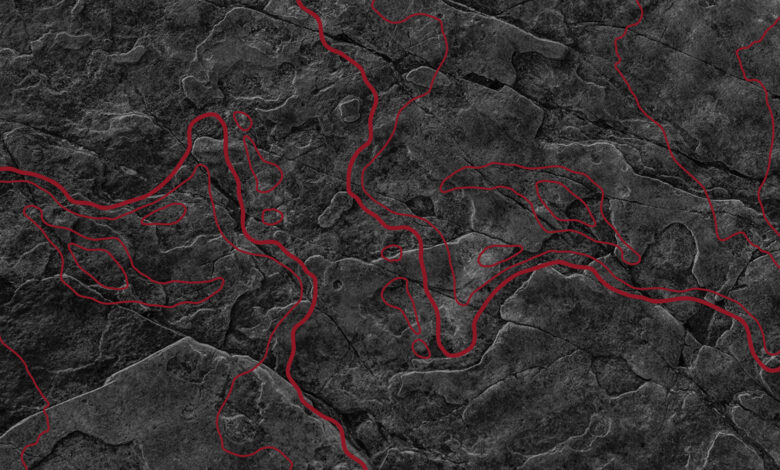
1.في سياق مسألة الضحية، تنتفي المسؤولية أيضاً عن الضحايا، لا أحد يسألهم. ما الذي علينا أن نُسائله لدى الضحايا؟ لكن هذا أيضاً ينزع إمكانية النقد، النقد الموجع حقاً، لكن الضروري للفعل. هم ضحايا لأنهم عجزوا عن النصر، وهذا العجز هو ذنبهم وهو ما يحتاج النقد.
2.لا يلغي هذا الدورَ الثوري لليبرالية تاريخياً، لكن علينا الإشارة إلى أن الليبرالية قدمت وقتها وعوداً تقوم على العقل والعلم والدعوة إلى خصخصة الدين باعتباره مصدراً لحروب لا تنتهي، في عصر لم يعرف العلم ولا العقل. اختلفَ المشهدُ اليوم بالكامل، العلم والعقل لا يحملان وراءهما أسئلة مفتوحة لا تملك إجابات فحسب (مسألة المعنى الباقية)، بل تاريخاً دموياً من الحروب والإبادات والانهيارات. وخصخصةً آلت إلى الاستهلاك والاستمتاع، مقارنة بروحية التقشف والعمل والجد التي طبعت الليبرالية المبكرة. إن الشرط التاريخي لليبرالية مسألة حاسمة.
يحارُ المرء في أن يُفصّل أو يفهم العلاقة التي تربط بين العرب وحروبهم العديدة التي تنهشهم. هل يخوضون حروبهم العديدة حقاً؟ أم أنهم مجرد وقود أو غنائم لهذه الحروب؟ كيف يمكن فهمُ علاقة السوريين بحربهم أو حروبهم؟ (والتردُّدُ بين صيغتَي المفرد والجمع مقصود، هل هي حرب أم حروب؟) كيف يمكن فهم علاقة السودانيين بحربهم؟ وكذلك الليبيين والفلسطينيين واليمنيين وغيرهم. هل تقتصر الحرب على الحروب الحارّة؟ أم يجب إدراج بلدانٍ أخرى مثل لبنان والصومال، أو حتى مصر، في خانة الحروب، حيث الاضطرابات والانتهاكات المستمرة واليومية التي تتباين حِدَّتها بشكل كبير؟
للوهلة الأولى، تبدو هذه الحروب مختلفة ومتباينة، تُخاض في مناطق مختلفة بين جماعات متباينة وفي سياقات شديدة الاختلاف. غير أن هذا الانطباع الأولي لا يشرحُ اجتماع هذه الحروب سوية في سياق زمني مشترك، والارتباطات العديدة التي تجمعها وتؤثر فيها لجهة أزمة النظام العربي (أو العالمي) الذي يجمعها، فهل يسمح هذا بالحديث عن حرب/احتراب عربي مُعمَّم؟ ومعه تصير الحرب في سوريا والسودان وفلسطين وغيرها لقطات من مشهد عام ومشترك، والتباينُ في الأسباب وأطر الحروب لا يعدو سوى أن يكون مظهراً خارجياً؟
كيف يمكن وصف هذه الحروب؟ هل هي حروب أهلية؟ ماذا عن الحرب الإسرائيلية على فلسطين/غزة وأهلها؟ أم هي حرب بين إسرائيل وحماس ولا يعدو الفلسطينيون أن يكونوا ضحايا هذه الحرب؟
في سوريا، هل هي حرب أهلية؟ حرب النظام ضد شعب ثائر؟ حرب أمراء الحرب في الشمال؟ حرب وكالة؟
هل في السودان حرب أهلية أم حرب ميليشيات؟ بافتراض إمكانية التفريق بينهما، بحيث أن حرب الميليشيات تفترضُ أن الشعب مُحايدٌ في صراع تخوضه الميليشيات، ودوره لا يتجاوز أن يكون الغنيمة لهذه الحرب.
*****
هي أسئلة متناثرة وعديدة، ويمكن متابعها في اتجاهات مغايرة أيضاً، تتعلّق بوصف الأشياء التي نتحدّث عنها والكيانات التي نعتقد أننا نراقبها بشكل مُحايد: سوري، فلسطيني، شعب، حرب.
ما الذي نعنيه بالعرب؟ هل نفترض، عند الحديث عن الشعوب مثل «الشعب السوري»، ذواتاً يمكن الإحالة إليها بوصفها تملك إرادة ورؤى موحّدة، تريد وتتوقع أشياء محددة؟ أم أن جزءاً من المعضلة المطروحة علينا في مواجهة هذه الحرب ومعاينتها ينشأ بسبب هذه الافتراضات، مثل وجود ذات تُسمى «الشعب السوري»، فيما لا يوجد سوى جماعات/أفراد عديدين، تسود بينهم الخشية والخصومة، والشعب السوري ليس سوى وهم (أو أسطورة) تسعى كل جماعة لاحتكار الكلام باسم هذا الكيان المتخيَّل، بوصفها جزءاً من الخطاب التسويغي لموقعها في النزاعات التي تخوضها، وبالتالي تحسين موقعها لجهة الشرعية والرمزية التي تحوزها أمام جماعات أخرى.
أليس الافتراضُ المبطن بوجود ذواتٍ خلفَ الأسماء التي نستخدمها، لوصف الجماعات أو الكيانات التي نتحدث عنها، جزءاً من المشكلة التي نواجهها في المَسعى لفهم ما يحدث أمامنا؟ مثلاً؛ الحديثُ عن شعب سوري بوصفه ذاتاً، سواء حُدِّدت إيجاباً باعتبارها ذاتاً فاعلة تريد شيئاً محدداً وتتصرف بطريقة معيّنة لتحقيقه، أو سلباً عبر تأثُّرها بسلوك فاعلين آخرين كأنْ تكونَ ضحية لما يقوم به الآخرون. هذا التذويت للكيانات؛ الشعب السوري هنا، يفرض تصورات وطُرُقاً معينة لإدراك المُشكل المطروح علينا، وتحميل المسؤولية وتَصوُّر المسارات والمُمكنات وبناء التوقعات.
إن الغاية من هذه الأسئلة العديدة هي الإشارة إلى حقيقة أن جزءاً أساسياً من المعضلة التي نواجهها يكمن في وصف المشهد الذي نواجهه، في الإمساك باللغة التي تصفه. وهذه اللغة، حتى فيما يتعلق بما نراقبه مُفترضين أنه أحداثٌ واقعية ولغةٌ واصفة حصراً، ليست لغة محايدة، إنما هي إيديولوجيا باعتبارها العدسة التي ننظر من خلالها إلى العالم من حولنا، نصفه ونرتبه ونعطيه معنى. وبهذا، فالتيهُ الذي نعيشه ناجمٌ، في بُعدِ أساسي منه، عن افتقارنا إلى هذه الإيديولوجيا الحائزة على إجماع مقبول، افتقارنا إلى اللغة المتفق عليها والتي تؤطر وتنظم خبراتنا.
*****
إننا نعجز حقاً عن إضفاء أي معنى على هذا الموت الدامي الذي نشهده أمامنا. الفاجعة التي تواجهنا هي غياب المعنى عن هذا الموت المُعمَّم، الذي يبدو مجرّد موت مجاني.
في عهود الثورات (على اختلاف أنواعها من ثورات التحرر الوطني حتى الثورات ضد الاستبداد) كان الموتى شهداء، كان لموتهم معنىً في سردية النضال التي تحفظهم في الذاكرة. حاز موتهم على المعنى في إطار المستقبل الذي قضوا في السبيل إليه، وهذا ما حفظ لحياتهم، كما موتهم، معنىً يتجاوز حيّزها الزماني والمكاني المباشر، وحيّزها الفردي المحض. في بدايات الثورات العربية المعاصرة شهدنا أمراً مماثلاً، كان الموتى شهداء، شهداء الحرية أو الكرامة، شهداء السعي إلى مستقبل أفضل. هناك في أفق ذلك المستقبل يكون لكل هذا الدمار والموت والتضحيات معنى، كما يحوز التاريخ وأحداثه على معقوليتها. المستقبل المرتقب والموعود هو ما يعطي للتاريخ مبدأه ومعناه، خلف كل هذه الأحداث المتنافرة.
لكن مع توالي الهزائم وانكسار الأحلام انتهى الحال بهذه السردية إلى النفي. لم يعد هناك معنىً لهذا الموت. نحن نموت وحسب، ضحايا (والنظر إلينا من زاوية الضحايا وتنظيم المساعدات وكأن هذه الفواجع تعود للطبيعة يُشير بطريقة ما أيضاً إلى أمر مشترك، أمام الكوارث الطبيعية نحن حصراً ضحايا. فأن يموت المرء في زلزال لا يجعل منه شيئاً سوى ضحية، لا بُعداً آخر لهذا الموت. وحده الفعل السياسي اللاحق ربما يمكن له أن يؤسس معنى يتجاوز وضعية الضحية، مثل أن يكون الزلزال نقطة تأسيس لتمرّد على نظام فاسد يتحمل مسؤولية سوء البنية التحتية التي انهارت وأدت إلى مثل هذه الوفيات. عندها يمكن للموتى أن يكونوا أكثر من ضحايا). نزعُ السياسة المرافق لنزع المعنى عن الموت هو ما يجعلنا ضحايا، كضحايا الكوارث الطبيعية الذين يحتاجون المساعدات.
تتقاطع الحالة الفلسطينية مع هذا التوجه، رغم وجود أساس أقوى لسردية تتمحور حول المقاومة والتحرير. فحجمُ الدمار الواقع على الفلسطينيين والنزاعُ الفلسطيني الداخلي أضعفا هذه السردية وحصراها في جموع معينة. حتى مع إدراك الفلسطينيين أن السلطة الفلسطينية ليست سوى سلطة عميلة، مثلها في ذلك مثل سلطة الحكم الذاتي التي اخترعها نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، فإن هذه السلطة لم تكتفِ بإيجاد قواعد اجتماعية واسعة لها في المجتمع الفلسطيني فحسب، إنما احتكرت أيضاً، ولو زوراً، إرث النضال الفلسطيني الذي مثّلته حركة فتح يوماً. بل إن توقيع أوسلو وبناء السلطة الفلسطينية في عهد عرفات فَتَحَ جرحاً عميقاً في السؤال حول معنى الموت، لماذا مات هؤلاء الشهداء جميعهم؟ إن ما حصلَ مع تأسيس السلطة الفلسطينية وتوقيع الاتفاقيات مع إسرائيل هو نزعُ المعنى عن موت هؤلاء.
*****
يُقدّم الليبرالي، بتقدير كل التنوعات الموجودة خلف هذا الاسم، صورة العالم الخاصة به، الصورة التي من خلالها يمكن لنا أن نمسك بما يحصل، نستوعبه ونفهمه ونعطيه معنى، وعليه نؤسس مواقف أخلاقية (استحساناً أو تقبيحاً) وفعلاً ما. يحدّثنا عن «شعب» يحب الحياة (وخطاب «حب الحياة» كان خطاب مواجهة لزمن طويل)، يريد أشياء، صدف أنها تتماثل مع ما يفترضه خطاب حقوق الإنسان الذي يستند إليه الليبرالي، الشعب (وبالأحرى أفراد هذا الشعب) يريد الحرية والعمل ورفاه الحياة والكرامة، ولهذا يجد نفسه في مرحلة أولى في مواجهة الاستبداد الذي يمنع عنه هذه الحقوق ويشن عليه الحرب، وفي مرحلة ثانية يجد نفسه ضحية لتنازع النظام (سواء كنا نتحدث عن نظام محلي أو نظام استعماري) مع ميليشيات إسلامية أو إثنية أو مرتزقة بكل بساطة، وهو يدفع ثمن هذا النزاع.
فالشعب السوري ضحية النظام الذي يذبحه لأنه أراد الكرامة، وضحية الميليشيات الإسلامية المتسلّطة عليه في المناطق المحررة، والميليشيا الكردية في الشمال الشرقي، كما أنه أيضاً ضحية مرتزقة الحرب لدى تركيا، إضافة إلى حرب القوى الخارجية على أرضه. السودانيون، أيضاً، ضحايا الحرب بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، وكذلك الفلسطينيون ضحايا حرب إسرائيل وحماس، ومثلهم اليمنيون والليبيون وهلم.
لو تُركت لهذه الشعوب إمكانية الاختيار لاختارت شكلاً كريماً للحياة، وفقَ ما يتصوره الليبرالي، كما كل الشعوب الأخرى (أو المتحضرة)، بافتراض أن بقية الشعوب تعيشُ هكذا.
هذا الخطاب في جوهره خطاب ضحية وخطاب أخلاقي. نحن ضحايا لجرائم وحشية ولا نجد ما نحتمي به سوى المرافعة الأخلاقية الصرفة في وجه هذه الجرائم. لا تلعب الإدانة الأخلاقية دوراً في إدانة الحرب فقط، إنما تساعد على احتمال الهزيمة، وإدامة الخطاب. فالضحية ومطلبها بتحقيق العدالة (وهو مطلب غير قابل للتحقق بكل بساطة لأن الضحية غير قادرة على الانتصار في الحرب أو تكبيد العدو ما يكفي من خسائر لجعله يدفع الثمن، ففي النهاية هي ضحية والضحايا لا ينتصرون، إنما يقفون للمراثي في خاتمة المشهد) هُما وقودُ هذا الخطاب ووقودُ قدرته على الحياة.
يقفُ الليبرالي عاجزاً أمام معضلة الموت، فلا يقدر على إضفاء معنىً عليه، مختزلاً إياه في كونه مصاباً يلحق بالناس. الموتى ضحايا وليسوا شهداء. هنا، يظهر رابط بين فكرة الليبرالي عن الموت-الضحية من جهة وواقع عمل المنظمات الإنسانية المندرجة في هذا النسق الفكري عموماً، والتعاطي مع ما يحصل في المشرق من منطلق الإغاثة ومساعدة المنكوبين. الموتى والجرحى واللاجئون والمهجرون، هؤلاء كلهم ضحايا يحتاجون العون والمساعدة. ضحايا الحرب أو ضحايا الكوارث الطبيعية، في الحالتين يبدو الموت مماثلاً، إنه أمر مأساوي بلا معنى يقع عليهم، ولا يمكن هنا سوى المساعدة على احتماله والتخفيف من أعبائه. هو يقع عليهم دون أن يكونوا هم مسؤولين عن هذا المصير بطريقة ما، باختيارهم للطريق الذي ساروا فيه على الأقل. وهذا يختلف عن الشهيد الذي يختار مصيره، حتى في لحظة العجز الكاملة أمام قاتله. الضحية لا يختار هذا المصير، هو يلقاه وحسب. مطلب العدالة للضحية يختلف، أيضاً، عن مطلب العدالة للشهيد. العدالة للشهيد لا تنفصل عن استكمال مسيرته، عن المستقبل الذي يمسك بمعنى الموت. العدل للضحية، سواء كان ضحية لنظام أو ضحية جريمة، ينحصر في تطبيق القانون، في تعويض المتضرر. العدالة لا تعطي الضحايا معنىً لموتهم، ما يعطي المعنى هو لحظة التأسيس لمستقبل آخر يكون تحقيقُ العدالة فيه جزءاً من إعادة تعريفها نفسه.1
لكن حتى تحقيق العدالة، يبدو أن الليبرالي عاجز عنه كونه ينفي القدرة على الفعل عن الناس. أدرك شميت مبكراً هذا النفي الليبرالي للسياسة، للفعل.
التصور المثالي للعالم بحسب الليبرالي يقوم على أفراد يجتمعون سوية لتحقيق أكبر قدر من الاستمتاع بهذه الحياة. إن التعاقد بينهم، وما يتمخَّض عنه من دولة العقد الاجتماعي ودولة المواطنين، يهدف إلى تحقيق الشرط الملائم لتحقيق أفضل شروط في هذه الحياة. القضايا الكبرى التي لا يمكن الفصل فيها، مثل الدين، لا يمكن طرحها على الحوار والمفاضلة والاختيار الديمقراطي، يتم حصرها في المجال الخاص. الخلاصة: خصخصة المعنى في مقابل عمومية التعاقد. وبهذا يكون الوعد الليبرالي هو الاستمتاع الفردي بالحياة، وترك الأمور الكبيرة باعتبارها خيارات شخصية.2
العلاقة الوحيدة الممكنة مع الموت، كواقع وإمكانية، انطلاقاً من التصور الفرداني، تكمن في تفادي السياسة، سواء بالهجرة أو التخلّي.
أليس مشروع تصفية (أو حلّ، كما يرغب المرء) القضية الفلسطينية ينطلق من تصور مشابه للقوى الكبرى مستنداً على فرضيات من هذا القبيل، نهضة اقتصادية عبر تدفق الأموال الأميركية والأوروبية إلى مناطق السلطة الفلسطينية وخلق طبقات وسطى مدينية تسعى إلى الاستمتاع بحياتها بما يلغي فكرة السياسة نفسها. الوطن، الشعب، الأمة، كلها تعبيرات تزول ليحل مكانها الفرد والنجاح المهني والاستمتاع بالحياة.
تنتهي الليبرالية إلى نفيها، في بلادها هي تعاني مع واقع سياسي طارئ يصبح فيه الخطر واقعاً، وعليها تعبئة الجمهور لمواجهة الخطر بما يفترض فكرة التضحية (مواجهة روسيا أو التضحية بمستوى الحياة الحالي). لكن في بلادنا، حيث الموت يتسيد على الجميع، تصبح المسألة أشد فداحة، فالهروب هو الحل، ومعه نفيُ السياسة. لا تقدم الليبرالية عزاء أو أملاً بما يمكنها من تأطير الموت في سردية معنى تؤهلها للفعل. هنا تحضر فقط فداحة المصاب، الضحية وأن لا تكون ضحية. لم تَعُد الليبرالية هنا أفقاً للتاريخ، التقدم، وسيادة العقل. فقد انحسرت الليبرالية في فضاء السوق والاستمتاع والاستهلاك، وكل مسائل المعنى الكبرى صارت قضايا شخصية، محصورة في الخيار الشخصي ولا تتجاوز هذا الحيّز.
لماذا عليك أن تحارب من أجل فلسطين، الديمقراطية، الوطن، أو أي شيء آخر. إن معنى حياتك ينحصر في الأشياء الصغيرة التي تشكل حياتك المباشرة، في خياراتك، في مسارك المهني، في استمتاعك اليومي. هنا، يبدو الموت نهاية، ومعه تصبح التضحية مصاباً علينا تفاديه بأي ثمن.
الليبرالية تفشلُ لأنها لا تستجب إلى رغبة ملّحة لما يتجاوز هذا، يمكن أن نسمي هذا التجاوز معنىً، يمكن أن نرى فيه فيضاً ميتافيزيقياً مميزاً للإنسان، يمكن أن نراه في شرط اجتماعي محض حيث أن القوي نفسه لا يستطيع إدامة هذا الاستمتاع. لكن الشيء الأكيد، هو أن الحاجة إلى معنى يرادف الحياة هو بدوره ما يجعل هذه الحياة ممكنة والموت من أجلها مسألة مُستحقة. لنكون ليبراليين، علينا أن نتخلى جوهرياً عن الليبرالية وأن نُضفي معنىً ما. هذا التناقض هو ما لا يمكن حله.
*****
يبدو الإسلاميون أكثر تماهياً مع هذه الحروب، وبالتالي أكثر مسؤولية. فالحروب هي حروبهم، سواء فُرضت عليهم عنوة أم اختاروها؛ هم طرفٌ فيها. والشعب بدوره، الذي يمثله الإسلاميون، هو أيضاً يخوض معهم معمعة هذه الحرب باعتباره البيئة الحاضنة لهذه المقاومة التي تمثّله وتعبر عمّا يرغب. أهل غزة ضحايا لعدوان إسرائيل لكنهم أيضاً مجتمعُ المقاومة، السوريون في مناطق سيطرة الإسلاميين أيضاً يخوضون حرباً ضد النظام، استمراراً لثورتهم. مثلهم اليمنيون مع الحوثي، والسودانيون مع الجيش، وهلّم. وبالتأكيد الأخصام يرون أن الشعب معهم وهم بدورهم يخوضون الحرب ضد الأولين، الشعب اليمني ضد الحوثي، الشعب السوداني ضد الجيشِ والثورةِ المضادة.
لكن الخطاب الإسلامي المتماهي مع الحرب يعاني بدوره من استعصاءات عسيرة. فالوعد الثوري للإسلام عاش تحولاته العديدة و المربكة، من علي شريعتي إلى أبو بكر البغدادي، من الإسلام الثوري الديمقراطي والمنحاز إلى المقهورين إلى إسلام المُفاصَلة مع العالم بأجمعه. هناك ما يبقى جامعاً في هذا الطريق وهو وعد الثورة وحضور المعنى للتضحية والجهاد (وليس محتوى المعنى ذاته بالتأكيد). المُفاصَلة، التي صارت مفصل المعنى في علاقة الإسلام مع العالم ومع نفسه، وسيادة اللحظة القيامية على هذه المواجهة، جعلتا كلفة المواجهة عالية جداً، كما أنها دفعت الغالبية إلى خندق الأعداء. لم يعد الوعد نصراً، إنما جهاداً وشهادةً دون نهاية. صار النصر موتاً مستداماً حتى يقضي الله أمراً.
لم يحفظ الإسلام الضحايا بوصفهم شهداء فحسب، إنما جعل من الجميع مشاريع شهداء، دون أي أفق آخر.
*****
في عشرينيات وثلاثينيات القرن المنصرم، وقف العديد من الاشتراكيين أمام مشهد مشابه في خضم الحروب الأهلية الأوروبية وصعود الفاشية والنازية. غير أنهم أمسكوا بلحظة مهمة في هذا المشهد (وهي تُمثّل الفارق عن مشهدنا)، كانت المسألة الفارقة هي التاريخ الخَلاصي/المسيحاني الذي كانتهُ الماديةُ التاريخية.
كتبَ جورج لوكاتش التاريخ والوعي الطبقي، التاريخ باعتباره مسرحاً لتحقيق الشيوعية/العقل المطلق، الذي يمتلك معناه النهائي في هذه المسيرة باتجاه الهدف النهائي؛ كل الأحداث تموضعت جنباً إلى جنب لترسم هذا الطريق المتعرّج، لكن الضروري، للوصول إلى الهدف النهائي. هناك، في النهاية يكون لكل ما يحصل معنىً. الطبقة العاملة أخذت مكان المسيح الذي عليه أن يحقق هذا التاريخ، ومثلَ آلام المسيح علينا أن نفهم آلام الطبقة العاملة بوصفها ضرورة تاريخية للتطهُّر، لتحقيق الوعي الذاتي. أنها الجلجلة التي لا بد منها للعبور إلى هناك، إلى أورشليم.
فالتر بنيامين سجَّلَ بدوره ملاحظاته حول التاريخ في لحظة مأساوية على المستوى الفردي، اليهوديُ الهارب من النازية الألمانية، والذي وجد نفسه موقوفاً على الحدود الإسبانية الفرنسية ومهدداً بتسليمه إلى النظام النازي، اختارَ الموت. لكن قبل هذا سجَّلَ لنا ملاحظاته حول التاريخ. أكد بنيامين على البعد المسيحاني والخَلاصي للمادية التاريخية، الماضي والمستقبل ينتظمان معاً ليرسما لنا سوية طريقاً للخلاص. عذاباتُ المضطهدين وصرخات المُعذَّبين تجد لنفسها مكاناً في هذا التاريخ، في الماضي الذي يملأ الحاضر. فالضحايا ليسوا وقائع تاريخية عارية في سردية المنتصرين، بل هي صرخات تعود من الماضي لشحذ الحاضر في مواجهة المنتصرين وتحقيق مستقبل مضاد. المادية التاريخية استعادت اللاهوت بشكل مادي.
ما عاد إليه كل من لوكاتش وبنيامين كان اللاهوت، الأساطير، ما يتجاوز الوقائع وبالتأكيد ما يتجاوز الأفراد، من أجل إعطاء معنىً لكل هذا الدمار في سياق التاريخ، ليكون هؤلاء الضحايا شهداء، ليكونوا عوناً على صنع المستقبل. ولكن هناك، في أفق ذلك المستقبل يقفُ مبدأ التاريخ، المبدأ الذي نفهم معه كل شيء في النهاية.
ألم يَقُل لنا بولس «فَإِنَّنَا نَنْظُرُ الآنَ فِي مِرْآةٍ، فِي لُغْزٍ، لكِنْ حِينَئِذٍ وَجْهًا لِوَجْهٍ. الآنَ أَعْرِفُ بَعْضَ الْمَعْرِفَةِ، لكِنْ حِينَئِذٍ سَأَعْرِفُ كَمَا عُرِفْتُ». لكن ما يغيب عنا هو المستقبل والإيمان سوية!
*****
ضحايا-أفراد، إن اختزالهم في لحظة الضحية يُعيقهم وينزعُ عنهم إمكانية أن يكون لصراخهم القدرة على تحفيز الحاضر. إن موتنا المجاني ليس واقعة بالأرقام، إنما هو تعبيرٌ عن غياب اللغة التي تسمح لنا بالإمساك بحياتنا، وإضفاء معنىً عليها يسمحُ لنا بالفعل. إننا لا نفهم، ولا شيء يساعدنا على هذا الفهم.
هذه هي الفاجعة التي نعيشها.




