حيادية الدولة في سورية (الفكرة والواقع.. من اليوتوبيا إلى الديستوبيا)/ علي سفر
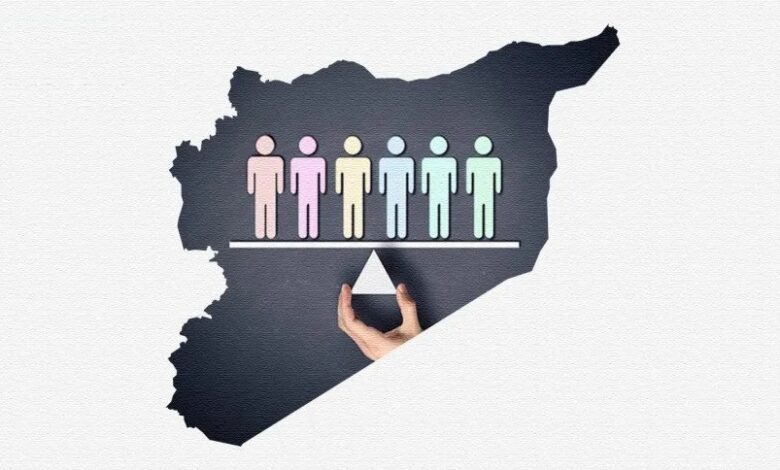
14 نيسان/أبريل ,2025
تنويه:
كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.
رئيس التحرير
خلال سنوات الثورة السورية، وربما قبل تفجرها، تراكمت في أذهان الثائرين صور متعددة عن شكل الدولة السورية في مرحلة ما بعد نظام الأسد، بعضها انطلق من قراءات متعمقة في الواقع ذاته، ولم يخرج بنتائج متكاملة[1]، وبعضها الآخر استقى معاييره من خلال مقاربة مفاهيم تعبّر عن إمكانية تشكيل نموذج إيجابي مستقبلي، كالديمقراطية وحقوق الإنسان، وفصل الدين عن الدولة[2]، وغير ذلك، وصولًا إلى حيادية الدولة.
الانطلاق من الجمود العام الذي أصاب المجتمع السوري خلال عقود الحكم البعثي لا يؤشر إلى إمكانية الوصول بسرعة إلى حالة المجتمع المثالي اليوتوبي (المدينة الفاضلة التي يتحقق فيها العدل والمساواة بين كل البشر)، بل هو يعرض وقائع تقول بأن على السوريين أن يعيدوا بناء واقعهم أولًا ليصبح قابلًا لمباشرة السياسة، ومن ثم ترك الفضاء العام الذي تشترك كل قوى المجتمع في صياغته يقرر في أي مسار سوف تمشي الأمور. أما البناء على المفاهيم المجردة، من دون إدماجها في الواقع ذاته، فإنه سيؤدي إلى حالة إحباط شديد لدى أصحابها، وذلك بسبب عدم قدرتهم على فرضها في الواقع، لا عبر إقناع الجمهور بها، ولا فرضها من خلال السلطة الحاكمة الجديدة.
في الوقت الحالي، حيث لا تتيح الرؤية قراءة معطيات وضع القوى السياسية في سورية وقدرتها على إحداث فرق في معادلة شكل الدولة العتيدة، أصبح الحديث عن حيادية الدولة أكثر تعقيدًا؛ إذ ثمة تيارات مختلفة داخل السلطة الحاكمة اليوم تسعى إلى فرض أفكارها وأيديولوجياتها على المجتمع السوري والترويج لأفكارها السلفية، في حين تحاول بعض التيارات الأخرى التكيف مع الضغوط الدولية لبناء صيغة حكم تشاركي، عبر حكومة تتسم بالتعددية والتوازن. في هذه البيئة السياسية المعقّدة، يصبح من الصعب تصوّر حياد الدولة، في ظلّ التباين الداخلي بين هذه التيارات، حيث يبدو ذلك فكرة يصعب تطبيقها على الأرض.
بالطبع، هناك فئات سورية تأمل في أن يتم العمل على بناء دولة محايدة، لكن من الضروري أن نعيد النظر في مفهوم الحياد في هذا السياق. فبينما كانت الحيادية تعني، في العديد من السياقات السياسية، إبعاد الدولة عن الانحياز إلى أي طرف، نجد أن الواقع السوري اليوم يتطلب إعادة بناء هذا المفهوم ليشمل التنوع الداخلي والتكيف مع التحديات الجديدة.
هل يمكن للدولة أن تكون حيادية في ظلّ حكم يتسم بالتناقضات الداخلية وتعدد المرجعيات الأيديولوجية؟ وهل يمكننا الوصول إلى نموذج يُسمح فيه لجميع الأطراف بالمشاركة في عملية بناء الدولة، دون فرض أي طرف لأيديولوجيته على الآخرين؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات تواكب هذا التحوّل الكبير في الواقع السوري.
حيادية الدولة مفهوم سياسي يعني أن الدولة محايدة إزاء القيم الثقافية والدينية للمواطنين. ويحاول هذا النموذج إبعاد الدولة عن التأثير في تحديد هويات مواطنيها. وينطلق هذا من فرضية أن الدولة يجب أن تضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، من دون أن تفرض عليهم نمطًا واحدًا من الحياة أو توجهًا معينًا.
لكن هل يمكن لهذا المفهوم أن يكون صالحًا في المجتمعات التي تتمتع بتنوع ثقافي وديني كبير مثل سورية؟ وهل الحياد في سياق سياسي مضطرب، كما هو الحال الآن، يعني فعلًا “العدالة للجميع”، أم أنه مجرد إقصاء للأقليات لصالح قوة الأغلبية؟
منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، بدأت تظهر تساؤلات حول شكل الدولة وعلاقتها بالمجتمع. وبينما تركزت المطالب الأولى حول إسقاط النظام، سرعان ما بدأت تظهر، خصوصًا في أوساط النخب السياسية والثقافية، تصورات متعددة عن “ما ينبغي أن تكون عليه الدولة المقبلة”.
في هذا السياق، برزت “حيادية الدولة” كمفهوم جذاب، مرتبط بتجارب دولية في الانتقال الديمقراطي، يُفترض أن يُجنّب الدولة السورية المستقبليّة الدخول في صراعات هوياتيّة، أو أن تتحوّل إلى أداة لفرض مشروع أيديولوجي بعينه. وقد صار هذا المفهوم، لدى العديد من المثقفين والسياسيين، شرطًا لتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية بعد عقود من الطغيان البعثي، حيث كانت الدولة منحازة بالكامل إلى حزب واحد، وشريحة سلطوية ضيقة[3].
لكن فعليًا، لم يكن هناك إجماع على هذا المفهوم، أو بالأحرى على صياغته بهذا الشكل. فقد عبّر بعض السوريين، خاصة في المناطق الثائرة، عن تخوّفهم من أن تتحول “حيادية الدولة” إلى خطاب نخبوي يُستخدم لإقصاء التعبيرات الدينية أو القومية أو الثقافية التي تشكّل جزءًا عضويًا من النسيج الاجتماعي. حيث رأى هؤلاء أن الحياد لا يعني تعقيم الدولة من الهوية، بل أن تنظر إلى وجود هويات متعددة للمجتمع، وأن تتعامل معها بإنصاف، لا أن تجبرها على الانكفاء أو الذوبان.
وفي بعض الأطر المعارضة، تحوّل الحديث عن الحياد إلى صراع بين من يريد دولة حديثة، مدنية، غير منحازة لا للدين ولا للطائفة ولا للأيديولوجية، وبين من يرى أن هذا الطرح ينطوي على مشروع يُفرَض من الأعلى من دون المرور بتجربة سياسية واجتماعية تنضج تدريجيًا[4].
وبين هذين الاتجاهين، نشأت طروحات أكثر براغماتية، تقبل بإمكانية أن تكون الدولة “منحازة مؤقتًا” لمرحلة انتقالية، بهدف تصحيح مظالم تاريخية، أو ترميم هوية منهكة، على أن تتجه لاحقًا نحو الحياد كهدف بعيد المدى.
لا يخفى هنا أن هذا الجدل يعبّر عن توتر حقيقي بين النظرية السياسية والواقع المركّب، بين الرغبة في إعادة تأسيس الدولة على قواعد جديدة، والخوف من عودة الاستبداد، ولكن بأقنعة مدنية.
الواقع السوري، اليوم، هو نتاج مرحلة طويلة من التسلط، واحتكار القرار، وغياب التنوع السياسي الفعلي. وعلى الرغم من إسقاط النظام، فإن القوى المجتمعية والسياسية لم تبدأ بعد في النقاش على أرضية سياسية صلبة، يمكن من خلالها الانتقال إلى مفهوم الدولة الحيادية.
من الواجب الاعتراف بأن سورية ليست مجتمعًا متجانسًا، كما يظن البعض، أو كما يرفع البعض الآخر الشعارات السياسية العامة، بل هي بيئة تعددية ثقافية ودينية وقومية تتداخل فيها الهويات بشكل معقد.
فهناك الأكراد والسريان والأشوريين الذين يرون أن حياد الدولة يعني احترام حقوقهم القومية والمناطقية، وهناك الطوائف الدينية أو ما تسمى بالأقليات التي تتخوف من أن حيادية الدولة قد تُسهم في تهميشهم لصالح مشاريع “أغلبية ديموغرافية سنّية” في مناطق معينة. وهذه الفئات تطالب -بشكل أو بآخر- بأن تكون الدولة منحازة لمصلحتهم في فترة معينة، لأنهم يعتبرون أن هذا الانحياز هو وسيلتهم لضمان التعايش بسلام مع الآخرين[5].
وبالطبع، لا يقتصر التباين على الهويات الطائفية والعرقية فقط، بل يتعداها إلى المجموعات السياسية المختلفة داخل المعارضة، التي تتنوع بين العلمانيين، والإسلاميين، والليبراليين، والمستقلين. فكل مجموعة ترى في “حيادية الدولة” تحديًا لرؤيتها السياسية، بل ربما تعدّها تهديدًا لمشروعها في إعادة بناء سورية.
من أكبر التحديات التي تواجه النقاش حول حيادية الدولة في سورية، غياب التعاقد السياسي الحقيقي بين مختلف الأطياف السورية. فالثورة التي بدأت كمحاولة للخروج من قبضة الاستبداد لم تستطع تأسيس رؤية سياسية مشتركة يمكن أن تتوحّد حولها مختلف القوى المعارضة. مع تعدد الفصائل، والمجموعات المسلحة، والأجسام السياسية، كان هناك دائمًا تصارع على الهوية السياسية: هل يجب أن تكون سورية دولة علمانية؟ أم دولة إسلامية؟ أم دولة تعددية تحترم كافة الهويات؟
غالبًا ما كانت تفتقر المبادرات التي ظهرت في هذا السياق إلى إجماع شعبي واسع، ولذلك، فإن دعوات كثير من القوى المعارضة إلى حيادية الدولة عُدّت مشاريع نخبويّة! تحاول فرض نموذج سياسي، يتجاهل التفاعلات الاجتماعية المعقدة بين مكونات المجتمع السوري. ومع ذلك، هناك مَن طرح رؤية أكثر مرونة، تقوم على فكرة أن الحياد يجب أن يكون هدفًا بعيد المدى، وفي المرحلة الانتقالية يجب منح الدولة قدرة على التدخل بشكل أكثر مرونة لتسوية النزاعات بين المجموعات المختلفة.
هذه الرؤية كانت تدافع عن فكرة أن الدولة يمكن أن تكون “منحازة” مؤقتًا لحقوق الأقليات، أو لمجموعات معرّضة للتهميش، على أن يُعاد توجيهها نحو الحياد التام بعد فترة من بناء المؤسسات، وتكريس قيم المواطنة المتساوية. لكن هذا الطرح يواجه انتقادات كبيرة من قبل فصائل معينة، ترى فيه محاولة لإعادة إنتاج شكل من أشكال السيطرة باسم “الحياد”، على حساب تمكين الأطراف الأخرى. وبذلك، يعكس هذا التباين في الطروحات السياسية وجود فجوات عميقة في الثقة بين مكونات المعارضة، وحتى في المجتمع المدني.
في ظل الفوضى الحالية التي يعيشها الجزء الأكبر من الأراضي السورية، فإن الوجود العسكري والسياسي للفصائل والجماعات المسلحة يزيد المسألة تعقيدًا. العديد من الفصائل -سواء كانت مدعومة من الخارج أو داخلية- لا تُظهر استعدادًا لقبول حيادية الدولة في ظل النزاع القائم، بل إن هناك خشية حقيقية من أن تطبيق الحياد في فترة انتقالية قد يُعدّ سعيًا نحو استبعاد فصيل أو طرف سياسي قوي لمصلحة طرف آخر. لذا، يتحوّل مفهوم حيادية الدولة إلى مطلب مستحيل، ما دامت الأرضية السياسية غير مستقرة، ولا القوى المحلية قد توصلت إلى توافق حول مستقبل البلاد.
عندما يدور الحديث عن حيادية الدولة في ظل هذه الظروف المعقدة، نجد أن الانتقال من اليوتوبيا إلى الديستوبيا (المدينة الفاسدة التي لا يتحقق فيها العدل ويتم فيها خراب الأرض) ليس مجرد انتقال بين حلم وتوقع كارثي، بل هو تحدٍّ حقيقي في كيفية تعايش هذه التصورات في مرحلة ما بعد الثورة. يمكن القول إن مسألة حيادية الدولة في سورية تقع بين فكيّ اليوتوبيا السياسية التي تحلم بدولة عادلة، وبين الديستوبيا التي تشهد على سيطرة النخب والتلاعب بالقيم السياسية لإعادة إنتاج الهويات القمعية.
في الواقع السوري الحالي، هناك خطر حقيقي من أن تتحول الحيادية إلى أداةٍ لتكريس الجمود السياسي، وأن تفتح الباب لاستبدال دكتاتوريات بأخرى، بل قد تتجاوز هذه الأنظمة فظاعة النظام السابق من خلال استخدام اللغة المدنية لتبرير الهيمنة والاحتكار السياسي الأمر الذي ينتهي بالسوريين إلى الديستوبيا.
إن رحلة التفكير في “حيادية الدولة” في سورية تفتح أبوابًا واسعة للنقاش حول العدالة، المواطنة، التعددية، والهوية الوطنية. وبينما نتمسك بفكرة بناء دولة تحترم حقوق جميع مواطنيها، وتتعامل مع تنوعهم الثقافي والديني والطائفي بشكل عادل، فإن هذه الفكرة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مسار طويل ومعقد.
إن الحياد ليس شعارًا يُرفع من دون التمحيص في شروطه المبدئية. هو ليس مجرد هروب من الانحياز، بل هو مشروع يتحقق ببطء عبر الاعتراف بالمظالم، وإعادة التوازن، والإصرار على وجود مساحة سياسية حقيقية يتم فيها التعامل مع التحديات بمرونة وتعدد.
في النهاية، إن التحدي الذي يواجه السوريين اليوم لا يقتصر على بناء دولة محايدة في المفهوم التقليدي، بل يتعلّق ببناء دولة تشاركية حقيقية، تتعامل مع التنوّع الأيديولوجي في الداخل، وتستجيب للضغوط الدولية. ويجب أن يشمل هذا التحدّي فكرة إعادة الإعمار السياسي والاجتماعي بشكل يتجاوز فرض نموذج واحد، ويستطيع أن يحترم كلّ التنوع الثقافي والديني الذي يميّز المجتمع السوري. وبذلك يمكن التفكير في الحياد ليس كهدف نهائي بحد ذاته، بل كعملية مستمرة من التفاهم والتعاون بين مختلف الأطراف، لتحقيق مستقبل يتسم بالعدالة والمساواة.
[1] قرأ الباحث الراحل سلامة كيلة مشكلة المفهوم في الواقع فقال: “حياديّة الدولة على أرض الواقع هي مهمّة جسيمة صعبة التحقيق، فـ “أصحاب الاختلافات” الذين يُفترض بالدولة أن تكون على مسافة واحدة منهم، يفترض بهم أيضًا أن يبقوا على مسافة واحدة منها، وعلاقة الفعل وردّ الفعل هذه بين الدولة والمختلفين من مواطنيها هي شرط أساسي من شروط تمكّن الدولة من أن تكون دولة حياديّة حقيقيّة، إلّا أنّ هذا الأمر ليس مضمونًا في معظم الأحوال، فأنماط الاختلاف الموجودة هي نفسها قادرة على تكوين قوى اجتماعيّة قابلة للتسييس أو قادرة على الضغط سياسيًّا على الدولة، بحيث تغدو عاملًا معرقلًا لفعلها الديمقراطيّ أو مؤثّرًا فيه، بحيث يحرفه عن مسار الاعتدال باتجاه إرادة أو مصلحة نمط الاختلاف المالك للقوّة”. انظر مقاله، في مجلة “صور”، على الرابط: https://2u.pw/kAJO6
[2] انظر قراءة بسام قوتلي المعنونة بـ “ما الذي نعنيه بحيادية الدولة؟”، على الرابط: https://2u.pw/oZaOT
[3] يفصِّل الباحثان حمزة رستناوي، وأحمد مولود الطيار في صياغة الدولة البعثية لهويتها، في بحثهما “حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين”، فيتحدثان عن فرض الهوية القومية العًربية للدولة السورية لتصبح عقيدة سياسية ملزمة، وليست مجرد انتماء ثقافي-حضاري. لقد رُسّخ هذا التوجه منًذ استلام حزب البعًث العًربي الًاشتراكي السلطة باعتباره حزبًا قائدًا للدولة والمجتمع. انظر البحث على الرابط المختصر: https://2u.pw/qQJM9
[4] يمكن اعتبار تداعيات قرار أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، في 28 آذار/ مارس الماضي، بإنشاء مجلس أعلى للإفتاء برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي، أنموذجًا لهذا الجدال، حيث ترى الكاتبة لمى قنوت أن الحديث عن مهام المجلس بحسب أعضائه يحوّله إلى جهاز فوق دستوري، فتقول إن “دور المجلس وفق الصلاحيات المذكورة أعلاه هو تقويض لبناء دولة حديثة، دولة القانون، الحيادية تجاه جميع مكوناتها وأيديولوجياتهم”!
انظر مقالة لمى قنوت، في جريدة عنب بلدي، على الرابط: https://2u.pw/c6xQv
[5] ارتفعت حدة النقاش حول الإعلان الدستوري السوري للمرحلة المؤقتة، حيث أعلنت جهات متعددة اعتراضها على بعض بنوده التي تهدد التنوع السوري، وعن هذا الأمر، تحدث الباحث الأستاذ الجامعي في باريس، تيغران يغافيان، في تقرير نشرته وكالة (فرانس برس)، فقال إن الأقليات “تشعر بقلق بالغ إزاء ما تؤول إليه الأمور؛ إذ إن المؤشرات كافة تشير إلى عملية تحول تدريجي إلى الجمهورية الإسلامية السورية»، معتبرًا ذلك بمثابة «صفعة لخطاب يروّج للتنوع والشمول”. انظر تقرير “الإعلان الدستوري السوري: مخاوف إزاء إدارة المرحلة الانتقالية” على الرابط: https://2u.pw/izTml
مركز حرمون




