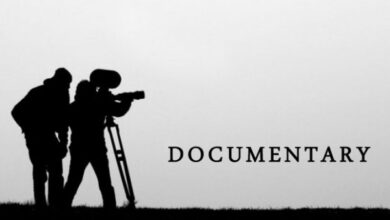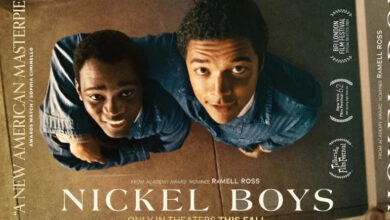حمص 2023: عن الفيلم الوثائقي «ذاكرتي مليئة بالأشباح»/ المنذر الدمني

16-04-2025
سقط نظام الأسد، ليتعايش السوريون منذ ذلك الحين مع الحدث ذي الأثر الأكبر والأكثر تأثيراً على حياتهم اليوم، وتخرجُ الكثير من السرديات السورية إلى العلن، سرديات المعتقلات والسجون، المعارضة والكتابة المخفية، التهجير والفقدان، الخوف والخذلان، سرديات مدن كاملة وعلاقتها الخاصة بكل ما جرى، ذاكرة الثورة والحرب التي تفرض زاوية رؤيةٍ تتجاوز ثنائية النصر والهزيمة. سقوطٌ جاء على نحوٍ مفاجئ مُعيداً لنا حقنا في الحزن العلني والغضب العلني والخوف العلني، بما يشمل نقاشات ما إن كان ما حدث انتصاراً أمّ أنَّ طريق النصر لا يزال طويلاً.
بعد سقوط النظام عادت مدينة حمص إلى واجهة الأخبار مجدداً، المدينة التي أُشيرَ لها يوماً باسم عاصمة الثورة، تعيشُ اليوم تحدياً بارزاً في ملّف السلم الأهلي، وواقعاً معقّداً مليئاً بالانتهاكات، يحمل أسئلةً عملية عن مبدأ تحقيق العدالة وكيفية تطبيقها، وعن تاريخ الثورة والحرب في هذه المدينة.
يرصدُ فيلم ذاكرتي مليئة بالأشباح الوثائقي للمخرج الفلسطيني السوري أنس زواهري واقعَ مدينة حمص قبل سقوط الأسد، زمنَ الهزيمة الصامتة والواقع الرمادي الذي جهّز لسقوطٍ مفاجئ.
حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة، مقدماً زاوية سردٍ هُمّشت بعد انتهاء الحرب المباشرة في أغلب المدن السورية؛ ما هو شكل علاقتنا مع مدننا في حاضر صامت ضبابي تسكنه أشباح الماضي، وفي غياب حتمي لأي عنصر من عناصر المستقبل؟ ما هو شكل يومياتنا وذكرياتنا؟ أين هي الحكاية الإنسانية التي تُعبّر بشكل أصدق عن الحكاية السياسية؟ يحاول فيلم زواهري الأخير الإجابة عن هذه الأسئلة، إذ يعيد طرحها أو يمشي بموازاتها، ويوثقها.
شبح المدينة
يصور الفيلم مدينة حمص عام 2023، مقدِّماً جزءاً من يوميات المدينة المعاصرة من خلال التجارب الحياتية لمجموعة من سكان حمص اليوم، فنرى حاضرهم ومخاوفهم ويومياتهم والأشباح في ذاكرتهم، ونرى العلاقة المعقدة مع المدينة، وتناقضات توصيفهم لها بين كونها ظالمة ومظلومة، مهمشة ومدمرة ومتعبة كأهلها، وهذا الشبه هو ما يجعل أهلها يؤنسنوها في أحاديثهم وتعبيراتهم عن الظلم، في هذه الأنسنة تعبير عن العلاقة المعقدة مع المكان وتاريخه؛ كيف نشعر تجاه المكان؟ هل نحبه ونحزن عليه؟ أم نغضب ونثور عليه؟ هل تعرّض لما تعرّضنا له؟ أم هو من عرّضنا لكل هذا؟ والأجوبة دائماً ما تأتي متناقضة، عاكسة لتعقيد الموقف السياسي الذي يلقي بظلاله على الجانب الاجتماعي، على شكل الحياة في المدينة وتجليات الخوف من الأطراف المتصارعة بعد تحوّل الثورة ضد النظام إلى حرب وحشية عبثية. كل هذه التناقضات تأخذنا في الفيلم لالتماس مفهوم الوحدة التي أصبحت حتمية، وأصبحت آلية للهرب ولِجلد الذات، ليست عقاباً ولا نجاة، بل حالة عالقة حتمية لدى سكان حمص، حالة عالقة تشبه حمص ذاتها.
نسمع على لسان إحدى الفتيات في الفيلم وصفاً للحياة الاجتماعية المليئة بالقهر اليوم، وكيف أصبح الحزن عنصراً أساسياً من عناصر الحياة في هذه المدينة، وكيف أن الخوف الذي يتمظهر على شكل نوبات هلع هو خوف مؤجل، لم يكن يُعبر عنه في سنوات الحرب المباشرة، وبدأ الآن، في مرحلة الهدوء ما بعد الدمار، يَخرج بأقسى وأبشع الطرق.
يُسأل شابٌ فاقد البصر عن لحظة العودة بعد سنوات كثيرة من التهجير والنزوح، يقول إنه في لحظة العودة لم يسمع أحداً يتحدث، كان الكل يبكي، ثم يَصفُ أن أصوات القذائف لم تكن تخيفه، بل أصوات الهدم بعدها، والآن هو ممتنٌّ لأنه عاد إلى مدينته دون أن يرى كيف أصبح حالها.
قصص الفقدان
ينتقل الفيلم من أسئلة الأشخاص عن المدينة وتجليّاتها في حياتهم بعد العودة، وعن شبحها في ذاكرتهم، إلى قصص الفقدان، إلى أشباح الأشخاص ذاتهم في ذاكرة من نجا.
يتحدث شاب عن فقدانه لأخيه الذي اختطفه الجيش الحر – من كانوا أصدقاءه في الحي – وبعد تحرره اعتقله أحد الأفرع الأمنية، ووصل خبر وفاته بعد سنتين إثر أزمة قلبية داخل المعتقل. يسرد الشاب القصة مع مخاوفه من عدم القدرة على الاستمرار، خصوصاً بعد وفاة والده ووالدته بعد رحيل أخيه، حيث بقيَ وحيداً في المنزل لا يعرف كيف له أن يستمر، ولكنه مستمرٌ.
تتحدث فتاة عن أبيها الذي قُتل إثر اشتباك في حمص، وبعد فترة ألقوا القبض على القتلة لكي تُوضع أمام خيار في أن تعفو عنهم وتتركهم للحق العام، أو ترفع دعوى قضائية وتأخذ تعويضاً مادياً، لتترك هذه القصة فتاةً بعمر 19 عاماً أمام سؤال كبير عن إمكانية تحقيق العدالة، وكيف لها أن تحققها في ظل الخيارات التي أمامها بطريقة تُنصف ذكرى أبيها؟
فتاة أخرى تروي مقتلَ والدتها بطريقة عنيفة على يد يافعين بعمر 14 و16 عاماً بهدف السرقة، تواجه هذه الفتاة أيضاً سؤالاً كبيراً عن تجليات العنف العبثية التي تركها بلا عائلة أو منزل، ودون حقٍّ بالغضب حتى أو تحقيق عدالة ما.
يسرد عسكري قصة أخذِه للخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء مروره بحاجز، لتتغير حياته في ليلة وضحاها، ويصبح عسكرياً على الجبهة بعد أن كان مغترباً يعمل في لبنان. يحكي قصة إصابة صديقه العسكري وكيف ترجاه ألا يتركه لمصيره وسط القذائف والرصاص، ليكون أمام أقسى لحظات حياته بعد عدة خسارات عاشها على الصعيد العاطفي والحياتي والمادي وحتى الإنساني.
تشترك هذه القصص كلها في انتمائها لعبثية الحرب التي أضاعت العدو المباشر، والغريم الذي يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يلقوا اللوم عليه، ومع غياب أي ملمح من ملامح العدالة أو سبيل لتحقيقها، ستكون الحرب هي غريمتهم الأساسية، الحرب التي جعلت من فقدانهم بلا جدوى، أو سبب، بل مجرّد فقدانٍ عبثي قاسٍ، ترك داخلهم أثار القسوة والخوف والعدم، بحيث يتحكم كل ذلك في شكل حياتهم اليومي، وفي إدراكهم للحياة وسلوكهم المغلف بكم هائل من الغضب والاختناق الذي لا يمكن توجيهه إلا للمكان، المكان الذي نشعر أننا نفقده كما نفقد أحبائنا، بطريقة عبثية.
تنتهي القصص مع أصوات شابة، شاب يتحدث عن حتمية الأمل كحقيقة تاريخية، ولكنه يتساءل عن شكله وخصوصيته في مدينة كحمص، الأمل بالسفر ربما. وتكمل فتاة حديثها عن العادي اليومي، عن تفاصيل بسيطة أصبحت تمثل النجاة لها، وهي أن ينتهي اليوم دون سماع خبر سيء، النجاة التي تتمثل بتقدير البساطة العادية التي أصبحت في الحرب تفاصيل لا تقدر بثمن، تعبر عن رغبتها بالسفر وعن خوفها من ترك المدينة قبل أن تقدم لها شيء ما.
مفهوم العادي
أظهرت اللغة الإخراجية للفيلم حرصاً على تعزيز التناقضات الشعورية التي حضرت في إجابات الأشخاص الذين وُجّهت لهم الأسئلة: أولاً في الكاميرا الثابتة طوال الفيلم (مدير تصوير: حمزة بلوق) التي ترصد لحظات متحركة داخلها لتفاصيل الحياة في المدينة، أو لحظات لأشخاص يقفون ويبتسمون للكاميرا بشكل متحرك داخل فضاءاتهم العشوائية البسيطة، كما ترصد لحظات للأشخاص الذين يسردون ذكرياتهم وهم في شوارع المدينة، أو في منازلهم يمارسون وحدتهم المطلقة. في هذا المستوى نرى علاقة الثابت والمتحرك التي تعبّر تماماً عن المدينة الثابتة ومحاولات الحركة والبحث عن الحياة البسيطة داخلها.
وفي المستوى الثاني نرى تناقضاً ما بين صوت المدينة (تسجيل صوت: مهيار شما) العادي المليء بأصوات العصافير وأصوات الشارع والأسواق، وصورة المدينة المدمرة التي تعكس الحالة النفسية للسكان؛ فالصوت هو حياتهم المجبرين على إكمالها داخل حالة من الدمار الساكن في ذواتهم ومكانهم.
أما في المستوى الثالث فيمكن أن نخوض في السرد السمعي للفيلم، فمع الشريط الصوتي المميز الذي أضفى واقعية ومصداقية، دون أي إضافات أو مشاعر زائفة لقصص الأشخاص، حيث أنّ سرد الأشخاص بحد ذاته كان مثير جداً للاهتمام، فقد كانوا يتحدثون ببساطة وعادية، وكأنهم أصبحوا من أصوات المدينة العادية وهم يتحدثون عن الموت والفقدان والحزن والضياع والخسارة. هذه البساطة خلقت علاقة تلقٍّ صادقة جداً، تدفع المتلقي للتفكُّر والشعور بهذه القصص من منظور الآن وهنا، من منظور الحاضر الذي جعل من ذاكرتنا حية، ومن وجودنا في الحاضر جامد، وفي هذا المستوى يصل التناقض إلى أعلى مستوياته الجمالية التي تعبّر عن روح المدينة الحقيقة اليوم، فقد سمعنا قصصاً في فضاء بصري مدمر، سمعنا قصص الأشخاص ولكننا لم نراهم يروونها، بل رأيناهم في فضاءاتهم ومدينتهم يمارسون وحدتهم، ويعبرون بشكل مقصود وغير مقصود عن المدينة وحاضرها وماضيها.
ينتهي الفيلم بكاميرا متحركة تمشي في شوارع المدينة فجراً، لا يوجد ما هو متحرك داخل كادر الكاميرا التي تحركت أخيراً مع الأصوات الشابة التي تتحدث عن حتمية الأمل، هنا يكتمل السرد البصري والسمعي ضمن لغة إخراجية مميزة كانت مُخلِصة للقصص، وعبّرت عنها ضمن رؤية جمالية في الصوت والصورة والمونتاج (علي قزويني)، وركبّت مفهوم «العادي البسيط» التي تحدّثت عنه الفتاة في النهاية، والواجب تقديره كنوع من أنواع النجاة والاستمرار في البقاء، مع المحافظة على أبسط أنواع الحياة. حملت اللغة الإخراجية خصوصية في إظهار جمالية خاصة للقبح والقسوة، تدعونا للتفكُّر بذاكرتنا وحاضرنا، وللتساؤل عن التصالح والاستمرار، وعن واقعية حتمية الأمل في واقع أصبحت الأشباح فيه جزءاً لا يتجزأ من المدينة التي نحاول أن نكتشف علاقتنا معها، علّنا ننجو ونكمل بعد هزيمتنا الكبرى وإجبارنا على البقاء ما بعد الهزيمة.
بعد سقوط الأسد، يمكن تلقي الفيلم بشكل مختلف، وإعادة طرح الأسئلة الأساسية عن العدالة الكبرى للمدينة بتخلّصها من الطاغية، وعن العدالة الحقيقة لناسها الذين فقدوا الأمل بتحقيقها، وأصبحت ذاكرتهم لعنة تلاحق وجودهم: ما هو شكل السلوك الواجب على المدينة وسكانها والقائمين عليها ممارسته بعد سقوط النظام؟ هل التخلص من الطاغية كافٍ للذهاب نحو العدالة والحرية التي حلمنا بها؟ أم أن لعنة الحرب الذي بدأها الطاغية أصبحت أكبر منه ولا يمكن تجاوزها فقط بزواله؟ سؤال واجبٌ من واقع المدينة الذي يفرض علينا التفريق ولو بشكل أولي ما بين سقوط النظام وانتصار الثورة، فانتصار الثورة السورية بخصوصيتها هي انتصار على لعنة الحرب وليس فقط على نظام الأسد.
موقع الجمهورية