سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 21 نيسان 2025
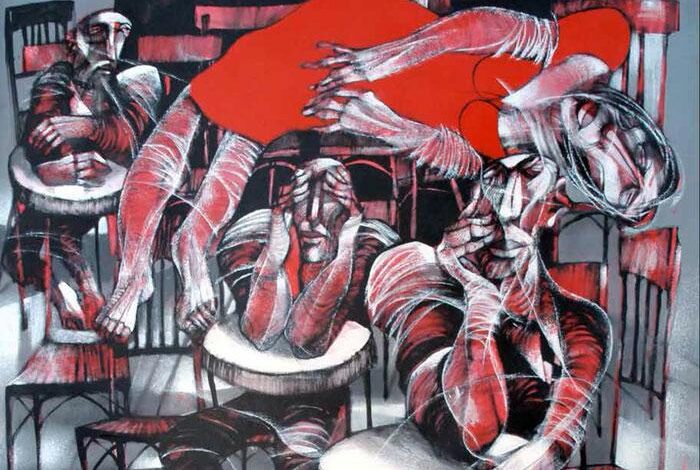
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
——————————————
سوريا ميدان النفوذ.. انكفاء واشنطن وتمدد أنقرة وقلق تل أبيب/ عبد الله مكسور
2025.04.21
“الفراغ في السياسة كما في الطبيعة، لا يلبث أن يُملأ، وغالبًا ما تملأه القوى الأكثر استعدادًا لا الأكثر شرعية.”، أتذكر هذا القول لنيكولا ميكافيللي وأمامي ترتسم الجغرافيا السورية بحدود سايكس بيكو الاستعمارية التي نعرفها، وفيها وعليها ترنُّ صدى الخُطى المتسارعة للقوى الإقليمية والدولية، لتتشكّل خارطة جديدة، تُرسم لا بالحدود بل بالقواعد العسكرية، ولا بالحكومات بل بمراكز السيطرة. سوريا التي مرَّت بسنوات عجاف تحت حكم نظام الأسد، تحوّلت بعد 8 ديسمبر 2024 إلى قلب معركة النفوذ- بشكل أو بآخر- بين تركيا وإسرائيل، في ظل انكفاء أميركي متدرّج، وغياب سوري موجع عن طاولة القرار.
سوريا اليوم في ظرفها الحالي ليست “دولة” بالمعنى التقليدي، بل ميدان، لا تُدار فيه النزاعات فحسب، بل تُختبر فيه الرؤى الكبرى لإعادة توزيع السلطة في الشرق الأوسط. واللافت أن الانسحاب الأميركي المرتقب ليس مجرد خطوة عسكرية، بل إعلان ضمني بانتهاء مرحلة وبدء أخرى، قوامها التفاهم التركي–الإسرائيلي الخفي، والمراهنة الروسية الباردة، ومحاولات سورية محلية لبناء دولة من ركام النظام القديم وعلى أنقاضه.
منذ سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر 2024، بدأت توازنات ما بعد الحرب تنقلب على رأسها وتظهر بشكل أكثر وضوحا. القوى التي ظلت لعقد كامل—تراقب، تُفاوض، تُناور—وجدت نفسها فجأة أمام فرصة تاريخية لتوسيع نفوذها وفرض رؤيتها للمنطقة. تركيا، التي لطالما نظرت إلى الشمال السوري باعتباره عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي، اندفعت بثقة نحو ما بعد خطوط الفصل، مستندةً إلى تفويض سياسي غير معلن جرى في كواليس باكو بين أنقرة وتل أبيب، وتحت رعاية موسكو غير المعلنة وغير الحاضرة رسمياً في أذربيجان.
في المقابل، لم تُخفِ إسرائيل قلقها، لكنها لم تواجهه بالصوت، بل بالتفاهم. فمع وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مجددًا، عاد منطق “الصفقات الكبرى” ليحكم السياسة الخارجية الأميركية، لا منطق “الالتزام طويل الأمد”. ترمب، الذي لا يرى في سوريا إلا ساحة عبء، اختار أن يُفرغها من الجنود لا من النفوذ، وأن يُسلّم أوراقها لحلفاء موثوقين، قادرين على إدارة مصالح واشنطن بأدوات إقليمية. وهكذا، وُلدت تفاهمات أذربيجان، بحسب ما تسرّب منها، مساحة عازلة لأنقرة، ومجال مراقبة آمن لتل أبيب، في مقابل انسحاب تكتيكي أميركي يُبقي اليد على الزناد حتى من دون أن يظهر.
لكن هذه الترتيبات لا تلغي الحقيقة المرّة: أن سوريا باتت اليوم مسرحًا لفائض القوة التركية، وهاجسًا أمنيًا دائمًا لتل أبيب، وحقل اختبار لمدى قدرة الروس على ملء الفراغ الأميركي من دون التورط في مستنقع جديد. فأنقرة تتحرك بثقة القوة الناعمة والصلبة معًا، من التعليم إلى الإدارة المحلية، ومن النفوذ العسكري إلى الشبكات الاقتصادية، في حين إسرائيل تراقب وتتدخل حين يلزم وفقا لمنطق اللزوم لديها، وتعيد تموضعها البري والجوي والاستخباراتي بما يتناسب مع ديناميكيات مرحلة ما بعد الأسد.
أما واشنطن، فرغم انسحابها المعلن، لا تزال تمسك بالخيوط الطويلة: تدفقات السلاح، نظم الرقابة الجوية، المنصات النفطية، وقنوات القرار الكردي. فهي تُغادر ولكن لا ترحل، وتسمح للآخرين بلعب الدور، لكنها تبقى المرجع الأعلى لمعادلات الأمن. هكذا، يتشكّل ميدان جديد في سوريا، ميدان بلا سيادة، بلا مركز، حيث تتزاحم الوصايات وتتماهى التحالفات. مشهدٌ يشبه رقعة شطرنج، لكنّ اللاعبين ليسوا متقابلين، بل متداخلين، وكلٌ منهم يمسك قطعةً من اللعبة، يحرّكها وفق منطقٍ لا يُقال أو يُعلَن، بل يُفهم من خريطة النفوذ. وكأننا ضمن مشهد في رواية “لاعب الشطرنج” لستيفان زفايغ على متن سفينة تمخر البحر في أميركا اللاتينية.
واشنطن تُغادر… لكنها لا ترحل
في الأدبيات العسكرية الأميركية تتردد الجملة التالية بشكل غير معلن: “الانسحاب لا يعني الرحيل، بل إعادة التموضع خلف الستار.”، فالحديث عن انسحاب أميركي من سوريا في أي مرحلة زمنية لم يكن يومًا حديث نهاية، بل إعلان عن تحول في نمط السيطرة. فواشنطن، التي دخلت الأراضي السورية في خريف 2014 تحت لافتة “التحالف الدولي لمحاربة داعش”، لم تكن تسعى إلى احتلال أرض، بل إلى احتلال قرار. والفرق بين الإثنين جوهري: فالأرض يمكن مغادرتها، أما القرار فالبقاء فيه يتخذ أشكالًا أكثر نعومةً وتأثيرًا. وعند التدقيق في طبيعة التمركز الأميركي في سوريا خلال العقد الأخير – رغم شح المعلومات عن عدد وحقيقة القواعد الأميركية في الأراضي السورية-، يتضح أنه كان أقرب إلى “الاحتلال الذكي” منه إلى الاحتلال التقليدي. ففي الشمال الشرقي، من رميلان إلى الحسكة، ومن الشدادي إلى التنف، أقامت الولايات المتحدة منظومة من القواعد العسكرية التي لا تتمدد أفقيًا بل عموديًا: تحت الأرض وفي السماء، ضمن قواعد قواعد اشتباك دقيقة، مفصّلة، ومتغيرة بحسب اللحظة السياسية والإقليمية. وبخلاف الرواية الرسمية التي أُطلقت عام 2014، بتركيز على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، فإن القواعد الأميركية في سوريا أُقيمت لأسباب استراتيجية تتجاوز ذلك التهديد العابر. فقد أدركت واشنطن منذ سنوات الفوضى الأولى أن سوريا ليست مجرد ساحة حرب، بل معبر ومفترق وملتقى. هي نقطة التقاء بين خطوط إمداد إيران إلى حزب الله، وبين الحدود الحساسة لإسرائيل، وبين الجغرافيا العميقة التي تمتد إلى الأنبار العراقية ومايليها حيث يتعاظم النفوذ الإيراني منذ عام 2003.
لهذا، كانت قاعدة “التنف” نموذجًا صارخًا لجوهر العقيدة العسكرية الأميركية الجديدة: قواعد صغيرة، مرنة، بلا مظاهر كبيرة، لكن ذات فعالية استخباراتية عالية، ومتموضعة على نقاط الخطر. التنف، الواقعة على مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، لم تكن قاعدة لمحاربة تنظيم الدولة فقط، بل لمراقبة التحركات الإيرانية بدقة، ولمنع الربط البري بين طهران وبيروت. كانت عين واشنطن على طريق الحرير الإيراني الجديد، وليس فقط على مقاتلي التنظيم المهزوم. وقد ساقتني الأقدار إلى لقاء مع ضابط خدم في التنف وقد أسرَّ لي عن استخدام القاعدة في مرحلة ما كسجن مؤقت لعناصر من تنظيم داعش قبل نقلهم إلى وجهات غير معلومة.
قواعد الاشتباك: جيوش تحت الوصاية
منذ اللحظة الأولى، لم تكتفِ واشنطن بتثبيت مواقع عسكرية، بل أسّست لشكل غير معلن من قواعد الاشتباك بين جميع القوى الفاعلة في الميدان السوري. فعبر دعمها لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، تمكنت من خلق جيش محلي بالوكالة، تديره بأدوات التمويل والتدريب، وتتحكم عبره بمساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا، وهذا ليس خافياً على أحد. لكن الدعم الأميركي لم يكن مطلقًا. بل جاء مشروطًا بخضوع هذا “الجيش الوكيل” لشبكة من التعليمات، تبدأ بحدود التحرك، ولا تنتهي بقوائم الأهداف. كانت قسد تعرف أن إطلاق رصاصة واحدة خارج التنسيق مع الأميركيين قد يُفقدها الدعم، وأن التحرك تجاه الحدود التركية أو الاقتراب من مناطق جيش نظام الأسد قد يُدخلها في عاصفة مع واشنطن.
ولعل أخطر ما كرّسته هذه العلاقة هو تعويم مفهوم “السيادة المنقوصة” في مناطق قسد، حيث بات القرار المحلي مشروطًا بإرادة القاعدة العسكرية القريبة، وتحديدًا تلك المنتشرة في رميلان والمالكية وشرقي دير الزور. وضمن منطق ضبط إيقاع الحرب والسلام لم تكن القواعد الأميركية معزولة، بل نسجت شبكة من العلاقات النشطة، إن لم نقل المُهيمنة، مع الفاعلين الإقليميين. مع تركيا، حافظت واشنطن على توازن هش، من خلال إرسال تطمينات استخباراتية، ومحاولة ضبط اندفاعات أنقرة نحو العمق السوري.
في حين أخذت هذه القواعد مع إسرائيل، شكلاً آخر فقد كانت ركيزة لتبادل المعلومات في إطار ما يمكن أن يتم تعريفه بـ”الاحتواء الذكي لإيران”. إذ لطالما مثّلت القواعد الأميركية في شرقي سوريا نقاط إنذار مبكر لأي تحرك إيراني قد يستهدف الجولان أو غيره، وهو ما اعتمدت عليه تل أبيب في كثير من عملياتها الجوية التي نفّذتها داخل سوريا خلال العقد الأخير.
أما مع روسيا، فكانت العلاقة أكثر تعقيدًا. فرغم العداء الظاهر، جرت تفاهمات تحت الطاولة يمكن تلمُّسها من اتفاق “عدم التصادم الجوي”، الذي قنن حركة الطائرات في سماء سوريا، وفصل مناطق السيطرة الأميركية عن تلك الروسية. هذه التفاهمات أوجدت نوعًا من “الهدنة الدائمة” بين القوتين، لكنها في الوقت نفسه ثبّتت حالة الانقسام الجغرافي لسوريا.
السؤال الجوهري الآن لماذا تُعلن واشنطن اليوم نيتها الرحيل؟ وهل هو فعلاً انسحاب، أم إعادة توزيع للقوة؟ المتابع يدرك أن الانسحاب لا يأتي من فراغ، بل من قراءة أميركية لتغير قواعد اللعبة. فسقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 أنهى توازنًا هشًا استمر لأكثر من عقد، وفتح الباب أمام فاعلين جدد – لا سيما تركيا – لملء الفراغ. كما أن تراجع التهديد الإيراني المباشر في الشرق قلّص مبررات البقاء العسكري الأميركي. إلى ذلك، هناك بُعد داخلي أميركي لا يُستهان به، وهذا يتمثل بالشارع الأميركي الذي لم يعد يتحمل وجود قواته في مناطق بلا أفق سياسي واضح، والنخبة السياسية التي ترى في الانسحاب “استثمارًا مقلوبًا” يقوم على الإنفاق المتزايد مقابل المكاسب السياسية المحدودة.
لكن هل ترحل واشنطن فعلاً؟ هنا يكمن جوهر المعادلة. الولايات المتحدة قد تسحب جنودها، لكنها لن تسحب نفوذها. فالمعسكرات التي تركتها وراءها درّبت أجيالًا من القادة المحليين، وغرست ثقافة القرار المؤسسي وفق الرؤية الأميركية. كما أن البنى الاستخباراتية التي بُنيت خلال السنوات العشر الماضية قادرة على البقاء من دون علم ظاهر. لقد أتقنت واشنطن وفق ما تعلمناه عنها لعبة “الوجود الغائب”: لا قواعد كبرى، لا أعلام، لا بيانات نارية، بل أدوات تحكم عن بُعد. كما لو أنها تُعيد إنتاج استعمار القرن الحادي والعشرين بنسخته الناعمة: تقنيات، شبكات، وكلاء… من دون الحاجة لدبابات أو جندي تقليدي يقف في الشارع. وفي ظل هذا النمط الجديد، قد يكون انسحاب واشنطن من سوريا أكبر دليل على استمرارها فيها. ذلك أن القوة الحقيقية، كما قال ميشال فوكو، لا تُقاس بوجود السلاح، بل بقدرة من يملك السلاح على فرض صمته في اللحظة المناسبة.
تركيا: من بوابة الحدود إلى قلب البادية
دخلت تركيا إلى شمالي سوريا تحت شعار مكافحة الإرهاب. لكن اليوم، بعد ديسمبر 2024، دخلت إلى قلب البلاد، من تدمر إلى البادية إلى مطار حماة، تحت شعار “إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية”. هذه ليست عملية أمنية بالمعنى التقليدي، بل مشروع نفوذ، يمكن مقاربته مع ما فعله العثمانيون في نهاية القرن التاسع عشر حين أنشأوا “قائمقاميات أمنية” في أطراف المشرق لضمان السيطرة على المركزـ مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات والمعاني والدلالات. فما يتم الحديث عنه اليوم بأن تركيا لا تبني مجرد قواعد عسكرية، بل بنية تحتية لنفوذ يبدو أنه طويل الأمد: نقاط مراقبة تحوّلت إلى معسكرات، ومعسكرات باتت تضم مراكز تدريب، ومراكز التدريب أصبحت مختبرًا يسهم بشكل أو بآخر بآليات إنتاج جيش سوري جديد، هذه القواعد لا تقوم على حدود الاشتباك بل على فلسفة التموضع، فكل قاعدة يتم الإشارة للتحضير لها في تدمر أو في محيط السخنة أو شرقي حماة ليست موضع تمركز عسكري فحسب، بل نقطة تَمثّل سياسي وتَوسّع مؤسسي، من خلالها تُصدّر أنقرة نسختها من الدولة “المنضبطة” التي تريد في سوريا، بما تحمله من مركزية وشبكات خدمات. وهكذا يجب فهمها والتعامل معها.
يمكن التوقف هنا عند تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال منتدى أنطاليا في فبراير 2025، والتي كانت أشبه ببيان تأسيسي لمرحلة جديدة. حيث قال: “تركيا ليست قوة احتلال، بل قوة استقرار. نحن لا ندخل الفراغ، بل نملؤه بأدوات البناء”، وهو بذلك لا يعبّر عن تحوّل في خطاب أنقرة فقط، بل عن نقلة في العقيدة التركية نفسها تجاه سوريا، عقيدة جديدة تنتقل من الحماية إلى الشراكة، ومن الأمن إلى الإدارة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزّز هذا التوجّه في خطابٍ وُصف بأنه “تاريخي”، حين قال: “نقف إلى جانب سوريا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وسنُسهم في إعادة بناء مؤسساتها بما يخدم وحدة ترابها وكرامة شعبها.” لكن ما لم يُقال، وما يُفهم بين السطور، هو أن “سوريا” هنا لم تعد الدولة بل المساحة، ولم تعد العلاقة التي تحكمها أخوّة الجغرافيا ومنطق المهاجرين والأنصار بل ضرورات التمركز الاستراتيجي الذي دفع أردوغان للقول بأن من يسعى إلى تقسيم سوريا عليه أن يواجه تركيا ذاتها.
في العمق من كل هذا، تسعى تركيا إلى صياغة واقع جديد على الأرض، يتجاوز فكرة “المنطقة الآمنة” التقليدية إلى “المجال الآمن الموسّع” الذي يمتد من اعزاز والباب بريف حلب، إلى الرقة ودير الزور، وصولًا إلى تدمر وخطوط البادية. ففي المحصلة لا تخفي تركيا أنها تتطلع لأن تكون القوة المرجعية في “سوريا الجديدة”، مستندةً إلى مقاربة هجينة تجمع بين القوّة الخشنة والناعمة، وبين السيادة المفككة والشرعية المتفاوض عليها. هي تُنشئ قواعد، لكنها تتحدّث عن المدارس، وتُسيّر أرتالًا عسكرية نشاهد صورها لكنها تدشّن شبكات مياه وكهرباء، وتبني ما تصفه بـ”العمق الاستراتيجي الاجتماعي”، كما ورد في أحد تقارير مراكز الدراسات الأمنية التركية. وهكذا، تمضي تركيا في مشروعها: لا كمجرّد لاعب عسكري، بل كفاعل سياسي يعمل على إعادة صياغة المركز من الأطراف، وفرض إيقاع تركي في قلب بلاد الشام، بحجّة إعادة البناء، وبهدف إعادة التموضع. والمفارقة أن هذا “التموضع” لا يصطدم فقط بإسرائيل أو بواشنطن، بل حتى بما تبقّى من “الدولة السورية” ذاتها في المستقبل القريب.
إسرائيل.. الخوف من حليف الأمس
إسرائيل التي كانت تُجاهر علنًا بعدائها لإيران، بدأت تهمس بقلقها من تركيا. القواعد التركية المزمع إقامتها في حماة وتدمر تمثّل، وفق المعنى الذي تسرَّب عن وصف جنرال إسرائيلي في محادثات باكو، “خطرًا غير مباشر لكنه أكثر ذكاءً”. فتركيا تبني جيشًا سوريًا لا يمكن التنبؤ بمآلاته، وتزرع أعينًا إلكترونية – من الرادارات والطائرات المسيّرة – على بُعد لا يتجاوز 500 كم من الجولان المحتل. فالقلق الإسرائيلي من أنقرة لا يتأتى هنا فقط من هذه الزاوية، بل من كفاءة هذا الوجود. فتل أبيب ترى في أنقرة منافسًا أمنيًا من نوع جديد “منافس لا يُشهر سلاحه، لكنه ينسج خرائط الولاء بهدوء”. وما التفاهمات التي جرت في أذربيجان سوى محاولة لتقنين هذا القلق، عبر إقامة “آلية تفادي الصِدام”، شبيهة بتلك التي أُبرمت مع الروس عام 2015.
في تقديري أن إسرائيل تشعر بوجود تركيا أنها أمام قوة ذات طابع إمبراطوري ناعم تستند إلى العاطفة، هذه القوة لا تسعى إلى الاجتياح بل لإعادة تدوير الهويات. وهذا يُشكّل خطرًا بنيويًا على فلسفة الردع الإسرائيلي التي بُنيت منذ حرب أكتوبر 1973 على فكرة: “السيطرة من الجو، والتفتيت على الأرض. ووفق قراءات استراتيجية فإن” تركيا تُقوّض هذه المعادلة من خلال السعي إلى توحيد الأرض السورية جزئيًا، تحت مظلة مرجعية تركية سواء كانت حاضرة أم غير حاضرة، تحاكي تجربة الباكستان مع أفغانستان في الثمانينيات، أو إيران مع “محور المقاومة” خلال العقدين الماضيين.
ثمّة قلق أعمق يراود المؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل، وهو أن الحليف الأميركي الذي كان يتولى “تنظيم المسرح السوري” لصالح تل أبيب، قد تراجع إلى خلف الستار، مفسحًا المجال أمام لاعبين أكثر مرونة، وأكثر شراسة على المدى الطويل. هنا، يظهر “التهديد التركي” ليس في القوة النارية، بل في القدرة على البناء المتراكم، في الزمن. إسرائيل تجيد الاشتباك مع عدو واضح، وتَربكها خصومة بطيئة تتقدّم بالطبقات والمساحة الاجتماعية لا بالصواريخ. والأخطر من كل ذلك، هو أن تركيا لا تُرسل رسائل مباشرة، بل تعمل بصمت، وتراهن على أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون محكومًا بالعجز الاستراتيجي وضبط الولايات المتحدة، فإسرائيل لا تستطيع ضرب أو استهداف قواعد تركية معلنة في تدمر أو غيرها من دون المجازفة بتفجير العلاقة مع الناتو، ولا تقدر على منع إنشاء شبكات النفوذ التركية داخل سوريا، لأن هذه الشبكات لا تُبنى بالدبابات، بل بالمنظمات غير الحكومية، والمناهج، والتدريب، والمياه، وربما بالرعاية الأوروبية والأميركية نفسها. لهذا يفكِّر العقل الإسرائيلي دائماً بوصف التمدد التركي بأنه الخصم الذي لا يحمل لافتة. وهو توصيف دقيق يعكس مأزقًا فكريًا يحمل التناقض في الطرح داخل العقل الإسرائيلي، فهل أنقرة حليف في الإقليم ضد طهران؟ أم منافس سري على النفوذ في سوريا؟ وهل يمكن الوثوق بمن يمدّ لك اليد في البحر المتوسط ويرمي عينه على البادية السورية؟
أمام هذه الأرضية يأتي الانكفاء الأميركي بعد ديسمبر 2024، وعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهذا ما زاد من اضطراب البوصلة الإسرائيلية. فالإدارة الجديدة في واشنطن أكثر انشغالًا بالصين والرسوم الجمركية وحدود المكسيك واللاجئين وبإعادة ترتيب البيت الداخلي، وأقلّ حماسًا لاستمرار دعم الخرائط الأمنية في المشرق. ترمب، براغماتيًا، لا يرى في الوجود التركي خطرًا، ظهر هذا جلياً فيما تسرَّب عن المحادثة الهاتفية بين ترمب أردوغان، ترمب يقول لأردوغان لقد أخذت سوريا، لقد فعلتها، وبهذا المنطق الترمبي يجد الأميركي غطاءً وفرصة لتقليص كلفة التورط الأميركي. لكن تل أبيب لا تشارك البيت الأبيض هذا الاطمئنان، هي لا تقرأ التحالفات بمصطلحات الميزانيات المالية وفق حسابات ترمب، بل بمفردات الوجود والنفوذ والذاكرة التاريخية والسردية الصهيونية.
ولهذا، بدأت إسرائيل تتحرّك على مستويات جديدة: تعزيز التنسيق الأمني مع اليونان وقبرص، فتح خطوط تواصل غير معلنة مع بعض المناطق في جنوبي سوريا، وتكثيف مراقبة البادية بالأقمار الاصطناعية، وحتى وصل بها الحال إلى تقديم مقترحات لنشر “قوات رمزية” أممية في بعض مناطق التماس مع إعلانها انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974. كل ذلك في محاولة لتثبيت وزنها في معادلة تزداد تسيّبًا، وتبتعد أكثر فأكثر عن الترسيم القديم لما يُسمّى بـ”سوريا المفيدة لإسرائيل”.، فتل أبيب تخاف من أن تستيقظ ذات يوم، وتجد أن سوريا لم تَعُد ساحة فوضى بل ساحة نفوذ مركّز، تُديرها أنقرة بهدوء، وتُراقبها موسكو ببرود، وتنسحب منها واشنطن بصمت.
باكو: منصة التفاهمات الجديدة
في مكان يمكن وصفه بالساحة غير الرسمية للتفاهمات المعقدة، جلس مسؤولون أتراك وإسرائيليون في أذربيجان، وهذا اللقاء ليس مجرد حدث عابر في منطق الأحداث في سوريا، فما تسرَّب عن محادثات أو مفاوضات أو اجتماع باكو يعني رسم خرائط جديدة للنفوذ، حيث تتقاطع مصالح الدول التي قد تظهر علنًا على خلاف، ولكنها تتفق في الخفاء على خطوط الاشتباك، والحديث هنا عن الطيران ومسارات الدوريات، ونقاط التحرك التي تبقى غير معلنة. هذه ليست مجرد محادثات دبلوماسية تقليدية، بل محاولات لتشكيل معادلات جديدة للأمن والنفوذ في المنطقة. الآلية التي سُمّيت بـ “تفادي التصادم” لم تكن في جوهرها سوى مقدمة لتفاهمات أعمق بكثير، تتجاوز الإطار الظاهر لتدخل في مفاوضات غير مرئية حول “من يسيطر على ماذا”، وما هي التنازلات التي يتم قبولها في إطار لعبة السلطة الإقليمية. وكما غابت سوريا عن الاجتماعات المتعلقة بمستقبلها في أنطاليا غابت عن اجتماع باكو، حتى لم يصدر من الدولة السورية الجديدة أي موقف مهما كان مستواه تجاه اللقاء والتفاهمات. لقد غابت دمشق عن الطاولة، رغم أن مصيرها هو المعني الأول بهذه التوافقات. تحضرني الآن تلك اللحظة التي نوقشت فيها جغرافيا الشرق الأوسط وتحولت إلى خرائط في بداية القرن العشرين، كنا غائبين والغياب فرض أن يرسم الحاضر ما يتصل بنا وبمستقبلنا الذي نعيش اليوم.
روسيا أيضاً غابت عن باكو، لكن حضورها في سوريا يبدو اليوم مثل “ظل” إمبراطورية كانت ذات يوم صاحبة اليد الطولى. موسكو تراقب بقلق بالغ كل قاعدة تركية جديدة تُبنى على الأرض السورية، لكنها تجد نفسها في موقف يمكن وضعه في خانة “العجز” أمام ضغوط أكبر تتعرض لها على جبهات أخرى، خاصة في أوكرانيا والعلاقة المعقدة مع حلف شمال الأطلسي. روسيا تدرك تمامًا أن أنقرة تتوسع في مناطق كانت حتى وقت قريب في دائرة النفوذ الروسي، ولكنها في الوقت نفسه لا تملك القدرة على ردعها بشكل حاسم في هذه المرحلة. ومع ذلك، تحافظ موسكو على “حق الاعتراض”.
في تصريحات له من أنطاليا، قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي: “نتشارك مع الروس الرؤية الأمنية في سوريا”. وهذه العبارة تبيّن أن التعاون بين أنقرة وموسكو ليس تحالفًا استراتيجيًا بالمعنى التقليدي، بل هو تحالف مصلحي يهدف إلى الحفاظ على حد أدنى من التوازن في المنطقة. روسيا قد لا تتدخل بشكل مباشر في المواجهات التركية-الإسرائيلية – فيما لو حدثت- على الأرض السورية، ولكنها تظل حاضرة بشكل غير مرئي، تراقب عن كثب كل تحرك قد يهدد مصالحها في المدى الطويل، وربما اختيار باكو لمسرح الظل في اللقاء الإسرائيلي التركي لم يكن بعيداً عن المظلة الروسية الحاضرة الغائبة لما تربط موسكو مع باكو من روابط.
سوريا: الغائب الحاضر
في قلب المعادلة السورية المعقدة اليوم، يغيب السؤال المركزي الذي كان يجب أن يكون في صدارة اهتمامات الجميع: ماذا عن سوريا نفسها؟ من يُمثّلها؟ من هو القادر على التفاوض باسمها؟ من يملك سلطة رسم حدودها، سياسياً وعسكرياً، سواء على الأرض أو في أروقة القوى الكبرى التي تتنازع النفوذ فيها؟
مع انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، واجهت سوريا – وما تزال- تحديات هائلة في تحديد هويتها السياسية الجديدة. الإدارة السورية الجديدة، التي تكونت بعد سقوط النظام، كانت في البداية مجرد حالة انتقالية تطرح رؤى مختلفة ومتناقضة تجاه القدرة على بناء مؤسسات قوية قادرة على إعادة استقرار الدولة. ورغم ذلك، فإن هذه الإدارة تعمل على تجاوز العثرات، إذ تجري – وفق ما يتسرب- تفاهمات خفية مع أنقرة، وتراهن على الدعم الروسي، وتخطو ببطء نحو إعادة بناء الجيش الوطني السوري بعيداً عن عقيدة جيش الأسد الذي تحول إلى مجرد جماعات متمردة وشظايا من بقايا السلطة أو ما اصطلح عليه سوريا ” الفلول”. حتى سياسياً تحاول الإدارة الجديدة أن تمثّل حالة القطيعة مع مسار نظام الأسد، وهذا يظهر جلياً في إصرارها السياسي وإلحاحها على أنها دولة سلام تريد صفر مشكلات مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل التي تحتل الجولان وتنفّذ توغّلات عسكرية وتوسِّع منطقتها العازلة، وتقصف في وضح النهار وظلام الليل ما تبقى من ترسانة عسكرية تتبع للدولة السورية، والصادم – وفق قراءات مختلفة- أن بيانات وزارة الخارجية السورية خرجت عن كل الثوابت السورية حين لم تصف إسرائيل بالاحتلال أو العدو أو الكيان وفق الأدبيات السورية منذ النكبة الفلسطينية.
وبالرغم من كل ما سبق إذا كانت الإدارة السورية الجديدة قادرة على جمع خيوط القرار الأمني في يد واحدة، فإننا قد نكون أمام مرحلة جديدة في تشكيل سوريا، مرحلة يتم فيها بناء جيش وطني جديد يحاكي النموذج التركي، مع إعادة تشكيل الولاء والعقيدة العسكرية بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية الحالية. هذه المرحلة لن تكون سهلة، لأن نجاحها يتطلب توافقًا سياسيًا داخليًا عالياً يتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية العميقة التي أسهم نظام الأسد في تفجيرها. ولكن، إذا نجحت سوريا الجديدة في إعادة بناء جيشها بشكل يتناسب مع التحديات الإقليمية، فإنها قد تنجح في تعزيز مكانتها في محيطها الجغرافي، إذا ما تم تضمين مبادئ من الاستقلالية العسكرية والتحكم الذاتي في قرارها الأمني.
من ناحية أخرى، فإن التفاهمات مع أنقرة، التي بدت أنها تؤتي ثمارها في الأشهر الأخيرة، تشير إلى تحول في العلاقات بين الطرفين، لا سيما في ظل التقارب الأمني التركي-السوري. تركيا تجد وتعتبر نفسها اليوم شريكًا ضروريًا للإدارة السورية الجديدة. لكن هذا التعاون لا يخلو من تحديات ومخاطر، خاصة في ظل حديث أنقرة عن إمكانية واحتمال تواجد دائم أو مؤقت على الأراضي السورية. ولا يخفى على أحد أن تركيا ترى في سوريا مجالاً لتثبيت نفوذها، وقد تتعامل مع هذه التفاهمات على أنها فرصة لتحقيق استراتيجيات أمنية تتجاوز محاربة “التنظيمات الإرهابية” لتصل إلى تعزيز قوتها في منطقة الشرق الأوسط.
أما روسيا، التي تعتبر اللاعب الرئيسي – سابقاً- في الملف السوري، فقد حافظت على وجودها العسكري والسياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، أرسلت رسائل مختلفة للإدارة السورية الجديدة وتراقب اليوم عن كثب كل تحرك للقوات التركية داخل الأراضي السورية، خصوصًا في المناطق التي تشكل نقطة تلاقٍ بين المصالح التركية والإيرانية. ومع تراجع الاهتمام الأميركي، تزداد أهمية الدور الروسي، الذي يبقى عائقًا أمام أي محاولات تركية للتوسع في المناطق الحساسة مثل الساحل السوري.
في هذا السياق، إن المرحلة التي تمر بها سوريا تتطلب إعادة هيكلة عميقة وشاملة ليس فقط للدولة بل للوعي أيضاً. وإذا استطاعت الإدارة السورية الجديدة جمع هذه الخيوط المتناثرة، فإنها قد تكون على أعتاب تشكيل جيش وطني قادر على التفاعل مع جميع القوى الكبرى في المنطقة، سواء كانت تلك القوى عربية أو غير عربية. وهذا البناء العسكري الجديد لن يكون مجرد رد فعل على الضغوط الخارجية، بل سيكون جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء سوريا جديدة تكون أكثر تماسكًا وأقل عرضة للانقسامات الداخلية.
سوريا اليوم تُشبه لوحة جغرافية متباينة الأطراف، تبحث فيها قوى إقليمية ودولية عن مصالح متباينة قد تكون متناقضة أحيانًا، لكنها تتقاطع في تفاصيل النزاع. من الشمال التركي إلى الجنوب السوري، مرورًا بظل أميركي يتقلص يوماً بعد يوم، ورقابة روسية سلبية، تظل سوريا تمثل ساحة اختبار حية للمصالح الإقليمية والدولية. بين الأطماع الإيرانية، والتحركات العسكرية التركية، والتفوق الإسرائيلي الأمني، تظل سوريا أرضًا منقسمة أكثر من كونها دولة واحدة قابلة للحكم والسيطرة. ورغم هذه التحديات، فإن سوريا ليست مجرد ساحة اختبار، بل قد تصبح ميدانًا يمكن أن يُعيد تشكيل قوة الدولة إذا توفرت شروط معينة يعرفها جيداً أصحاب القرار.
التاريخ علمنا أن الميادين التي تتنازعها القوى الكبرى قد تُنتج كيانات جديدة قادرة على النهوض. ففي غياب الدور الأميركي الفاعل، وقدرة روسيا على تقديم نموذج متوازن يعزز استقرارًا داخليًا، لا يوجد من يملأ الفراغ في سوريا سوى من يملك القدرة على فرض إرادته على الأرض. ويبدو أن هذا هو ما سيحدث في الفترة القادمة، حيث قد يؤدي الانسحاب الأميركي التدريجي إلى انكشاف حقيقة أن القوى الفاعلة على الأرض هي التي تكتب مستقبل سوريا. وعلى الرغم من ذلك، تبقى سوريا اليوم في موقع متأرجح بين التطلعات الوطنية والضغط الإقليمي، بين محاولات بناء جيش سوري جديد وبين تقاطع مصالح القوى الأجنبية التي تسيطر على أجزاء من أراضيها. مع كل قاعدة تُبنى، ومع كل طائرة تحلق في سمائها، ومع كل صفقة تُعقد خارج حدودها، تُكتب صفحة جديدة في كتاب تاريخ سوريا الذي سنكون شهوداً عليه. وما نريد أن نشهد عليه حقاً هو أن تنجح الإدارة السورية الجديدة في فرض نفسها كمحور أساسي على طاولة التفاوض الإقليمية، وإعادة بناء الدولة السورية ككيان متماسك وفاعل من دون قواعد عسكرية أجنبية أو انتهاك للسيادة.
تلفزيون سوريا
——————————————
المشهد الإسلامي الراهن في سوريا/ حسام جزماتي
2025.04.21
في «مؤتمر النصر» المنعقد في 29 كانون الثاني الفائت، والذي وضع أسس المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد؛ لم تعلن الفصائل فقط عن حل نفسها بما فيها «هيئة تحرير الشام»، بل أيضاً عن حل «حزب البعث العربي الاشتراكي» الذي كان حاكماً، فضلاً عن الأحزاب الشريكة له في «الجبهة الوطنية التقدمية»، وكذلك عن حل «الأجسام الثورية السياسية والمدنية» ودمجها في مؤسسات الدولة الجديدة «استكمالاً لنضالها وتعزيزاً لدورها» كما نص البيان الصادر عن الاجتماع.
في «مؤتمر النصر» المنعقد في 29 كانون الثاني الفائت، والذي وضع أسس المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد؛ لم تعلن الفصائل فقط عن حل نفسها بما فيها «هيئة تحرير الشام»، بل أيضاً عن حل «حزب البعث العربي الاشتراكي» الذي كان حاكماً، فضلاً عن الأحزاب الشريكة له في «الجبهة الوطنية التقدمية»، وكذلك عن حل «الأجسام الثورية السياسية والمدنية» ودمجها في مؤسسات الدولة الجديدة «استكمالاً لنضالها وتعزيزاً لدورها» كما نص البيان الصادر عن الاجتماع.
بعد أقل من شهر، وفي محفل آخر عرف بالاسم المهيب «مؤتمر الحوار الوطني السوري»، كان هناك رجل وحيد مجرد من تنظيمه. ذاك هو الدكتور عامر البوسلامة، المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا، الذي استجاب لشروط العهد الجديد بالحضور بصفته الفردية، عضواً في لجنة «البناء الدستوري».
يتحفظ «الإخوان» السوريون عند الحديث عن علاقتهم بالحكم القائم في دمشق، أملاً في أن يكون الجفاء الفعلي الواقع مجرد سوء تفاهم سيجري حله بين «الإخوة» مهما تباعدوا، ولذلك يحذرون من طرحه في العلن لئلا يتصلب ويغدو نهائياً. يعوّلون قليلاً فقط على تولي بعض أبناء الإخوان، من الذين نشؤوا في الخارج، مناصب متوسطة، لأن هؤلاء اختيروا بصفاتهم الفردية أيضاً. يغصّون عندما يلاحظون أن فصيلاً محسوباً على التيار الجهادي سحب من تحتهم البساط الإسلامي بضربة واحدة، وأنه يعاملهم معاملة سواهم من الأحزاب والجمعيات ويرفض استقبالهم ككتلة. ويتأسفون حين يراقبون شعبيته التي صعدت فجأة في الأوساط السنّية التي كانت محسوبة لهم تقليدياً، فيما صاروا، في نظر الجمهور، شركاء في فشل هياكل المعارضة؛ المجلس الوطني والائتلاف وهيئة التفاوض، التي لم يعد الناس يرغبون في السماع باسمها إلا في ورقة نعي تغلق تلك الصفحة الطويلة وغير المجدية من انسداد الأفق.
وفي حين يقلّب الإخوان أفكارهم باحثين عن حل لهذه المعضلات؛ يعاند تنظيم إسلامي آخر، هو «حزب التحرير»، الحكم الجديد في البلاد كما سبق أن قاومه عندما كانت سيطرته تقتصر على إدلب. ففي سجن حارم ما يزال أقل من أربعين من منسوبي الحزب يرفضون أن يوقّعوا على تعهد بالامتناع عن انتقاد السلطة الجديدة علناً مقابل الإفراج عنهم. وفي حين أن فرع الحزب في «ولاية سوريا» قد توقف عن تنظيم التظاهرات المعارضة، كما كان يفعل منذ عام مضى، فإن اتفاقاً رسمياً لم يثبّت ذلك، وما زالت منصات الحزب تكرر دعوته إلى استعادة دولة الخلافة.
ومن جهته أعلن تنظيم «حراس الدين» عن حل نفسه في توقيت جدير بالملاحظة إذ سبق «مؤتمر النصر» بيوم واحد فقط. فقد نشر هذا الفرع الرسمي لتنظيم «القاعدة» بياناً قال فيه إن مبرر وجوده كان نصرة أهل سوريا في وجه سلطان جائر ظالم، قتل واغتصب وسجن وشرّد مسلمي «أهل السنّة في الشام المباركة». لكن هذه المرحلة انتهت بانتصار الشعب على الطاغية واكتملت المرحلة. ولذلك يعلن الفرع عن الحل «بقرار أميري من القيادة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد». ناصحاً أهل الشام بعدم ترك سلاحهم، ووجهائهم وكذلك «من يتصدرون المشهد اليوم» بإقامة الدين وتحكيم الشريعة. وبذلك أزيح عن طريق «هيئة تحرير الشام»، التي ستعيش بعد ذلك ليوم واحد نظرياً، خصم مكين كان قد نازعها على الشرعية الجهادية، ودخل أعضاؤه سجونها في السنوات الماضية.
أما داعش فقد اتخذت موقفاً مزدوجاً لاعتبارين مختلفين. فمن ناحية مركزية ونظرية رأت في سيطرة عدوها، منذ «جبهة النصرة»، على الأراضي السورية مجرد تبديل بين علمانيتين لكل منهما نكهة مختلفة عن الأخرى. مدلِّلة على ذلك بخطاب الانفتاح الذي صدّره قادة الإدارة الجديدة تجاه الدول الغربية في الخارج ونحو الأقليات في الخارج. أما من ناحية محلية عملية فقد توقفت عمليات التنظيم في المناطق التي انتقلت من سيطرة نظام الأسد إلى الحكم الجديد على الرغم من أنها كانت أقوى مناطق نفوذه وقوته الضاربة، في حين استمرت هجماته، بالوتيرة نفسها، في مناطق سلطة قسد.
من غير المستبعد أن يكون تحييد هاتين الجهتين؛ القاعدة وداعش، نتيجة اتفاقات قسرية مخفية لعب فيها توازن القوى دوره الحاسم. فمن المعروف أن أمن «هيئة تحرير الشام» امتلك، عبر السنين، أوراق ضغط مؤثرة على داعش، في حين كان «حراس الدين» مكشوفين له بالكامل في مناطق سيطرته، ومستنزفين في الأفراد والتمويل.
لكن مشكلات «هيئة تحرير الشام» (المنحلة؟) في الوسط الديني أكبر من هذه التنظيمات الأربعة رغم ذلك. فمن جهة أولى تتعرض لضغط من القاعدة والوسط إلى القمة، ومن الشرعيين إلى السياسيين، لحجز حصة أكبر للشريعة من الدولة الوليدة، أو، على الأقل، حرية «الدعوة» لتعزيز الأفكار الإسلامية في المجتمع ليكون داعماً في سبيل «التمكين». وهو ما يثير على الدوام احتكاكات بين الدعويين وبين الرافضين، مما يضطر السلطات إلى تحجيم دور الأولين وصولاً إلى احتجازهم.
ومن جهة ثانية وصلت «هيئة تحرير الشام» إلى المدن الكبرى ذات الثقل المشيخي، ولا سيما دمشق وحلب، وقد سبقها توجس كبير من الأوساط التقليدية من محاولة فرض المنهج السلفي. ولذلك تحاول السلطة الجديدة بعناية أن تبدد هذا التصور عنها بالتقرب من كبار العلماء وتعيينهم في المناصب المركزية في وزارة الأوقاف وفي «مجلس الإفتاء الأعلى» الذي صُمم بعناية لاستيعاب ممثلي مراكز التعليم الديني الكبرى. وكذلك يجري التعامل بحذر كبير مع قرارات منع بعض الشيوخ عن الخطابة أو تهميش آخرين بنقلهم. وفي كلتا الحالتين يؤخذ في الاعتبار موقف الخطيب من الثورة أكثر من معتقده الأشعري أو طريقه الصوفي. رغم أن هذه الأمور قد تندرج في سلة واحدة بحكم تركيبة الوسط الديني السوري الذي فرض على مسؤولي الأوقاف الجدد السير على صراط يومي رهيف، بين الضغوط من داخل «الهيئة» ومن خارجها.
تلفزيون سوريا
————————————
قيامة سورية وخلاصها من مقبرة الأسد/ عمر كوش
20 ابريل 2025
دشّن سقوط نظام الأسد قيامة سورية جديدة بكل معنى الكلمة، وباتت تشبه ذلك الإنسان الخارج من القبر حديثاً، المنهك والمتهتك، الذي لا يكفّ عن التلفّت يمنة ويسرة، محاولاً اكتشاف طريقه وما هو حوله، وبحاجة إلى المساعدة، ومدّ يد العون من أبنائه ومحبيه وسواهم، وينطبق على ناسها تعبير “survivors” الذي يطلق على مَن عادوا إلى الحياة، أو بالأحرى نجحوا في البقاء على قيد الحياة. وفي ثقافتنا السورية نقول للذين يتفادون حادثاً مميتاً “انكتب لهم عمر جديد”، ونجد التعبير نفسه في ثقافات أخرى.
ليس مبالغة ألبتّة القول إنّ سورية خرجت من مقبرة وضعها فيها نظام الأسد، وبات ناسها ناجين، يحتاجون في حياتهم إلى الكثير، ليتمكّنوا من التغلب على تحدّيات أمنية واقتصادية وسياسة جمّة. وبالتالي، هناك مسؤولية كبيرة على النخب الفكرية والسياسية السورية من أجل العمل على إنجاح تجربة إسقاط الأسد، ليس انتصاراً للسلطة الحاكمة، بل من أجل الوقوف إلى جانب عموم السوريين وإنقاذ بلادهم من سيناريوهات كارثية.
لا يعني الوقوف إلى جانب البلد وناسه التسليم بكل ما تقوم به الإدارة الجديدة، بل العمل بلا كللٍ من أجل الدفاع عن الحريات العامة والخاصة، وبناء مسار يفضي إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون، وانتقاد كل خطوة أو مظهر سلبي، من دون الاصطفاف في خانة العداوة لكل ما تقوم به السلطات الجديدة، وذلك لاستكمال خلاص الناجين السوريين، ووقوف البلد على قدميها، ما يعني أيضاً عدم الارتهان إلى التأييد الأعمى لكل ما تقوم به هذه السلطات، ولا إلى الحقد الأعمى الذي يُبديه بعض بقايا اليسار واليمين، حيال التحوّل السوري عبر رفض كل خطوة تقوم بها، من دون النظر في أبعادها، والترحيب بأي موقف أوروبي أو أميركي مناهض لها، والذي يصل إلى حدّ تأييد الاشتراطات الغربية التي يُراد بها الابتزاز.
كانت مُستغربةً مطالبة بعض من يترأسون أحزاباً، لا يتجاوز عدد أعضاء كل منها عدد أصابع اليدين، بأن تسلم السلطات الجديدة الحكم لهم أو لسواهم، بزعم إنهم دعاة العلمانية والليبرالية. ومُستغربٌ أكثر توقع أن تكون السلطات الجديدة حاملة مثل هذه القيم، ونسيان أنها تمثّل مجموعة إسلامية في طَوْر التحوّل. والأهم عدم الوعي بأن الوصول إلى تحقيق الديمقراطية وسواها من القيم الحديث، يتطلب السير في مسار شاقٍّ وطويل، وتقديم تضحياتٍ لم يقدّموها هم، وبذل كثير من العمل من أجل بناء مسار دولة المواطنة والتعددية، وبدلاً من ذلك راح بعضهم يستمرأ تضخيم الأخطاء والهفوات، ويتمادى في استغلال الجرائم المدانة بشدة، التي ارتكبت في الساحل السوري، وقاده نهج التضخيم والمبالغة إلى اعتبار المجازر بحقّ مدنيين من الطائفة العلوية فيه حرب “إبادة جماعية” للعلويين، في حين أن المنظمات الحقوقية الدولية التي وثقت الانتهاكات، لم تضعها في هذه الخانة، بل اعتبرتها منظمّة العفو الدولية ضمن “جرائم الحرب”.
لافتٌ أن الارتكاس الطائفي واعتماد لغة التحريض لم يقودا إلى تحميل السلطات الجديدة مسؤولية مجازر الساحل فحسب، بل إلى التمادي في اللعب على الكلمات في محاولةٍ من بعضهم تبرئة نظام الأسد من جرائمه، فاعتبر أحدهم المجزرة الرهيبة التي ارتكبها نظام الأسد في غوطتَي دمشق عام 2013 مجرّد “هجمات كيمياوية” أمام مجازر العلويين، وراح يتساءل عن أي دولةٍ ينتسب إليها العلويون، وكأنه عاد إلى موقعه الطائفي، بدلاً من وضع الأمور في نصابها، وإدانة كل المجازر والانتهاكات التي ارتكبت بحق غالبية السوريين أكثر من خمسة عقود من حكم آل الأسد الأقلوي والطائفي.
تحتاج قيامة سورية إلى اعتماد خطاب عقلاني وهادئ، واتخاذ مواقف متوازنة من جميع أبنائها، بعيداً عن التحريض والتخندق في مستنقع الانتماءات ما قبل المدنية، والارتقاء بكل أصنافها إلى مصافّ الانتماء الوطني الجامع، بغية ترميم الهوية السورية، والسعي إلى إبراز ممكنات بناء الثقة بين مكوّنات الشعب السوري، وتحقيق العدالة الانتقالية بغية الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة. وهي مسؤوليةٌ لا تقع على عاتق السلطات الحاكمة الجديدة فحسب، بل على عاتق جميع السوريين، كل من موقعه، وحسب إمكاناته وقدراته، والأهم فهم طبيعة المرحلة والتحديات الجمّة والعمل على إنجاح التجربة، من أجل أن يحيا الناجون من مقبرة نظام الأسد حياة جديدة وكريمة.
المؤسف أن المعارضة التي يبديها بعضهم حيال سورية الجديدة لم تعد تنحصر في نقد أطروحات السلطة الجديدة ومواقفها، ولا طرح في تقديم برامج سياسية وفكرية واجتماعية من أجل إعادة بناء سورية والمشاركة في تقرير مستقبلها، بل أضحت أسلوب حياة، ونمطاً من التفكير الرغبوي، وطريقة للنقّ من دون النقد، وموقعاً لتصنيع هويات اجتماعية وسياسية، توزّع كيف ما اتفق، الأمر الذي يجعل من المعارضة صنعةً إلى حدّ كبير، ويحوّلها، على نحوٍ مباشر أو غير مباشر، إلى نوع من نوستالجيا للعهد البائد، فيما المطلوب منها أن تحدث قطيعة نهائية معه. والمؤسف أنه نشأت في المقلب الآخر موجات محاباة للسلطة الجديدة، تريد تأبيد حكم الإسلاميين، لتشكّل مجموعات من الشبّيحة الجدد. وهنا تكمن المفارقة في الارتكاس والتقهقر إلى دائرة الاستقطاب الطائفي المقيتة.
خروج سورية من مقبرة الأسد وخلاصها من قبضة نظامه ليس سوى بداية مسار شاقّ وطويل، تعتريه عقباتٌ سياسيةٌ واجتماعيةٌ كثيرة، وتحدّياتٌ داخليةٌ جمّة. وعلى الرغم من أن سورية الجديدة أنهت عقوداً مديدة من الاستبداد، إلّا أن حالات الغموض ما تزال تعتريها، وتتقاذفها أحلام بناء وطن يتسع لجميع أبنائه، ونوبات من الكراهية والانقسام. وبالتالي؛ مهمة إزالة العقبات التي تعتري طريقها تقع على كاهل جميع أبنائها، فهم مطالبون بالعمل على إزالة الشروخ الاجتماعية والانقسامات التي يغذّيها خطاب طائفي مقيت، يصدر عن نخبٍ كان بعضها يرفع راية الحداثة، ولا تقتصر مهمّة التصدي له على المثقفين فحسب، بل على السلطات الجديدة، وعموم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمنخرطين في الفضاء العمومي، الذين سيحاسبهم التاريخ إن لم يقفوا ضد كل مظاهر التحريض والكراهية، وانحازوا إلى موقع المصفقين أو المحرضين.
العربي الجديد
——————————
في الحاجة الملحّة إلى السياسة/ حسان الأسود
21 ابريل 2025
لطالما كان الناس خارج إطار السياسة بمفهومها المباشر، فلم يكن للرعايا حقوق المشاركة في صناعة المسار واتخاذ القرار، طوال عشرات القرون الماضية من عُمر البشرية. دخل الناس السياسة من بابها الضيّق مع التغيّرات الاجتماعية الكُبرى، التي أفرزتها الثورة الصناعية، فكان أن سُمح لهم بالمشاركة في التصويت من خلال الانتخابات، لأنّها تخدم الهدف النهائي لكسر احتكار الإقطاع وسائلَ الإنتاج. كانت المكاسب الحقوقية والسياسية انعكاساً لحاجة رأس المال دخول الأفراد معترك الشأن العام، ولم يكن هذا الأمر كرمَ أخلاقٍ من الفئات التي احتكرت السياسة، بل حاجةً ملحّةً لتنظيم المجتمعات التي خرجت من القرى وفكّت ارتباطاتها بالبيئة الزراعية وانتقلت إلى المدن، وبات لديها علاقات جديدة مختلفة من حيث المصالح والتبعيّة. عندما انتظم العمّال في جمعيات محلّية بسيطة للدفاع عن مصالحهم، وعندما تحوّلت الجمعيات هذه إلى نقابات كبيرة وقويّة، وبعد أن انتقلت الكنيسة وراء رعاياها للبقاء على مقربة منهم والاستمرار في التواصل معهم، ازداد الشعور بالقوّة الجماعية، فكان هذا أحد أسباب فتح ثغرة في جدار المشاركة السياسية لاحقاً، التي أخذت بالتوسّع المستمرّ، حتى وصلت إلى ما نعرفه الآن، بعد أن تحوّل الرعايا مواطنين.
تراكمت المكتسبات العامّة للأفراد في الغرب عندما بدأ التزاوج بين الديمقراطية والليبرالية، فالمشاركة في الشأن العام اقترنت بتوسّع دائرة الحقوق والحرّيات. ومع مرور الزمن، أصبح من المستحيل الفصل بين المفهومين. لكنّ الأمر لم يسرِ في هذا النهج في بلدان العالم الثالث، والتي انتقلت إليها الديمقراطية والحرّيات عبر التأثر بالغرب من خلال الاستعمار المباشر أو بالتبعيّة الثقافية. وُلدت الديمقراطية عرجاء في هذه البلدان، فكانت غطاءً شكلياً لاستئثار الحكّام الديكتاتوريين بالسلطة في الجمهوريات المختلفة، كما هو الحال في روسيا وإيران، وجمهوريات الموز في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. أمّا الحقوق والحرّيات فبقيت سجينةً في سطور الدساتير والقوانين، ولم تخرج منها إلى ساحات الممارسة الفعليّة ضمن مؤسّسات الدولة أو ضمن الحيّزَين الاجتماعي والثقافي لهذه البلدان. الخطير في التحوّلات الماضية، التي يشهدها العالم منذ إعلان عصر الحرب على الإرهاب بعد أحداث “11 سبتمبر” (2001)، هو توسيع مساحة الممارسة الديمقراطية شكلاً وتضييق مساحة الحرّيات موضوعاً، حتى في الدول الغربية المصنّفة ديمقراطيةً عتيقةً، فيها رسوخٌ واضح لقيمها ولقيم الحرّيات والحقوق تقليدياً. يتجلّى هذا اقتصادياً في حالات الإفقار المتزايدة للطبقات المتوسّطة، وسياسياً بارتفاع أسهم اليمينَين المحافظ والمُتطرّف، وثقافياً بالارتداد عن قيم التسامح والتعدّد وقبول الآخر المختلف.
حسب أبرز مؤشّرات الديمقراطية العالمية، التي هي برامج تقيس حالة الديمقراطية في مختلف الدول، وتعتمد معاييرَ متنوّعةً تحاول تقييم جوانب مختلفة في حياة الشعوب والدول، مثل الحقوق السياسية، والحرّيات المدنية، والعمليات الانتخابية، والمشاركة السياسية، وثقافة الديمقراطية، وأداء الحكومة. ووفق أحدث التقارير الصادرة عنها (في 2024 – 2025)، ثمّة خشية من تراجع خطيرٍ للديمقراطية والليبرالية على مستوى العالم. يمكن الإشارة سريعاً إلى أبرز نتائج دراسة نُشرت أخيراً في هذا الخصوص. فأولاً، تراجع متوسّط مستوى الديمقراطية، إذ سجّل مؤشّر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية في عام 2024 إلى أدنى مستوىً له على الإطلاق. وبالمثل، يشير تقرير V-Dem لعام 2025 إلى أن مستوى الديمقراطية للمواطن العالمي العادي عاد إلى مستويات عام 1985، وأن متوسّط مستوى الديمقراطية على مستوى الدول عاد إلى مستويات عام 1996. ثانياً، ازداد عدد الأنظمة السلطوية باضطراد على مدى العقد الماضي. في عام 2024، كان هناك عدد أقلّ من الديمقراطيات (88) مقارنةً بالأنظمة السلطوية (91)، للمرّة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً وفقاً لـV-Dem.
ثالثاً، انخفضت نسبة سكّان العالم الذين يعيشون في ظلّ “ديمقراطية كاملة” إلى 6.6% في عام 2024، مقارنة بـ12.5% في عام 2014 (تقرير EIU). في المقابل، يعيش 39.2% من سكّان العالم تحت حكم أنظمة سلطوية. كما تدهورت (رابعاً) الحرّيات المدنية وحرية التعبير. فيشير تقرير V-Dem إلى أن حرية التعبير هي المكوّن الأكثر تضرّراً في الديمقراطية، إذ تدهورت في 44 دولة في عام 2024. كما تراجعت نزاهة الانتخابات وحرية تكوين الجمعيات وحكم القانون في العديد من البلدان.
وخامساً، لا تزال “الموجة الثالثة” من التراجع الديمقراطي مستمرّةً منذ 25 عاماً على الأقلّ، فتشهد 45 دولة حالياً تراجعاً في مستوى الديمقراطية (تقرير V-Dem). وعلى الرغم من أن عام 2024 شهد انتخابات في العديد من البلدان، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى تحوّل كبير في الاتجاه العالمي للديمقراطية. فقد تدهور مستوى الديمقراطية في عدد أكبر من البلدان التي أجريت فيها انتخابات مقارنةً بتلك التي شهدت تحسّناً. وأخيراً، سجّل مؤشّر أداء الحكومة التابع لمؤشّر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية أكبر انخفاض في عام 2024، ممّا يسلّط الضوء على أزمة أوسع في الحوكمة تؤثّر في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية على حدّ سواء.
تشير هذه الدراسات بشكل جليّ إلى انحسار تأثير الجماهير في الشأن العام بشكل مضطرد، وهذا يعني أنّ السياسة بدأت تعود لتصبح شأناً حصرياً لمجموعة قليلة من المجتمع، كما كان الحال سابقاً قبل الثورة الصناعية. هذه الفئة هي الأكثر ثراءً ونفوذاً في الدول المصنّفة ديمقراطيةً كاملةً، فكيف هو الحال إذاً في الدول المصنّفة ديمقراطيةً جزئياً أو المصنّفة استبداديةً؟ وكيف هو الحال في الدول الخارجة من ثورات مثل سورية، أو حروب أهلية مثل السودان؟… الوضع بحاجة إلى كثير من العمل الجاد، فمن دون إعادة تشكيل الفضاء العمومي بشكل يسمح بأوسع مشاركة سياسية للشرائح المجتمعية كلّها، لن يكون بالإمكان حلّ المشكلات المستعصية في هذه البلدان، وفي مجتمعاتها المتأخّرة كثيراً عن ركب الحضارة والمدنية.
المشاركة السياسية ليست ترفاً، بل ضرورة ملحّة لتفادي إعادة إنتاج الاستبداد من جهة، وللحاق بركب التطوّر من جهة ثانية. لا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه في بلداننا الخارجة من ثورات وصراعات دموية شديدة، ولا بدّ من اختراقات بنيوية لإعادة تشكيل الحياة العامّة، ومن دون ذلك سنبقى على هوامش الحياة، وفي طيّ النسيان.
العربي الجديد
————————–
كيف يعيد بعض المدافعين عن السلطة إنتاج القمع؟/ علي سفر
2025.04.21
يختلف شكل الهجوم على الانتقادات والمنتقدين من شخص إلى آخر. فبعضهم يستخدم أقذع الشتائم، بما يذكّر بشبيحة النظام السابق في السنوات الأولى للثورة، والبعض الآخر يكتفي بالتشكيك بالنيات.
في زمن النظام الأسدي، اعتاد السوريون ممارسة نوع من النقد لمؤسسات الدولة، نقدٌ محدود ومضبوط بين حين وآخر، يتركز أساسًا على السماح للجمهور بانتقاد الموظفين ورؤسائهم والمديرين والمديرين العامين. وفي بعض الأحيان، حين “تحمرّ عين الرئيس” على وزيرٍ ما، يُوجَّه بعض الصحفيين لكتابة نقدٍ له في إحدى الصحف الرسمية، لتبدأ بعدها طقوس سوقه إلى مصيره المحتوم: إقالته من منصبه، وربما محاكمته إذا كان “ذنبه لا يُغتفر”. وقد يتطور الأمر أحيانًا ليطول رئيس الحكومة، ما يشير إلى قرب إقالته.
ضمن هذه الخطوط الدقيقة، دأب السوريون على كتابة الشكاوى عبر ما يُعرف بـ”الرقابة الشعبية”، وكان من المفهوم أن السقف محدود، ولن يتجاوز موظفًا فاسدًا (غير مدعوم) هنا، أو آخر مرتشيًا هناك. فالجميع يعرف المعادلة وعناصرها المُعلنة، كما أن عناصر الأمن والمخابرات كانوا يؤيدون هذا النوع من النقد، ويصفون أصحابه بأنهم وطنيون يؤدون واجبهم تحت سقف الوطن!
لكن في زمن الثورة، انكمشت الرقابة الشعبية تحت وطأة قعقعة السلاح، والخوف من نزق مؤيدي الأسد، واتقاءً لشرِّ من قد يفهم الملاحظات الطبيعية على أنها تشكيك بالنظام، ما قد يوقع صاحبها في مشكلة لا تُحلّ إلا في أحد الأقبية الأمنية، بعد أن يُتهم بأنه معارض يعمل لصالح جهة ما!
في ظلّ مواجهة الأسديين للثورة الشعبية العارمة، صارت الكلمة التي كانوا يتسامحون معها سابقًا تخيفهم، حتى وإن كانت تستهدف الفاسدين المعروفين.
ولن يكون مستغربًا أن كثيرين ممن انتهى بهم المطاف ضحايا تحت التعذيب، إنما دفعوا حياتهم ثمنًا لشكاوى عادية قرأها مخبرٌ ما على أنها مؤامرة ضد الأسد!
لكن الانهيار الاقتصادي في السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام، وبعد إعلان “الانتصار على المؤامرة الكونية”، أدى إلى عودة حذرة للرقابة الشعبية. بات المرء يقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي نقدًا متزايدًا لبعض المسؤولين وسخرية صريحة منهم، طبعًا ضمن السقوف المعتادة، ومن دون تجاوز الخطوط الحمراء.
لكن بعض المواطنين في الساحل السوري تجرؤوا في السنة الأخيرة وكسروا القواعد، فوصل انتقادهم إلى رأس النظام، ما أدى إلى اعتقالهم، ولم يُفرَج عنهم إلا بعد فتح السجون على يد مقاتلي إدارة العمليات العسكرية، في سياق عملية “ردع العدوان”.
يظن السوريون أنهم انتهوا رسميًا من الرقابة التي كانت تُمارس على انتقاداتهم، وهم محقّون فيما يعتقدون، إذ لم يصدر حتى الآن أي قرار يفرض حظرًا على التعبير عن الرأي أو تقديم الشكاوى. فالجميع لديه الحق في قول ما يشاء، باستثناء المحظور الوحيد المعلن عنه في الإعلان الدستوري، وهو تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه. إذ يُعدّ إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يُعاقب عليها القانون (المادة 49). كما تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة (المادة 13).
غير أن نمطًا سلوكيًا عاد إلى الواجهة في الصفحات التي تتابع الشأن السوري الداخلي، يتمثل في قيام كثيرين بمهاجمة أي انتقاد للسلطة الجديدة، من خلال توجيه الشتائم المقذعة للمنتقدين، والتمسّك بسؤالٍ يتكرر: “أين كنتم خلال 14 سنة من عمر الثورة؟” – في محاولة لحرمان الناس من ممارسة حقهم في النقد، والتعبير عمّا لا يرضيهم من ممارسات “المحررين”.
فالمُنتقد، حتى وإن كان تاريخه في مواجهة القمع واضحًا، وسبق أن اعتُقل في سجون المخابرات، يُنمّط مسبقًا على أنه كان صامتًا راضيًا بحكم الأسد، وبالتالي، فإن من رضي بالذل والهوان الأسديين لا يحق له الشكوى من ممارسات المنتصرين الذين أسقطوا السلطة الديكتاتورية الغاشمة!
يختلف شكل الهجوم على الانتقادات والمنتقدين من شخص إلى آخر. فبعضهم يستخدم أقذع الشتائم، بما يذكّر بشبيحة النظام السابق في السنوات الأولى للثورة، والبعض الآخر يكتفي بالتشكيك بالنيات. لكن الجوهر المشترك بينهم هو الإيمان بأن السلطة الجديدة، وبحكم أنها أنجزت إسقاط الأسد، فهي معصومة عن الخطأ، ويجب أن تُمنح فرصة، وأن الأخطاء الظاهرة هي فقط “ممارسات فردية”.
وثمة فئة منهم تستعيد قاموسها القديم، بعد أن “كَوَعت”، وباتت ترى أن من مصلحتها الذهاب إلى أقصى درجات التطرف في الدفاع عن حكومة الرئيس أحمد الشرع، لحماية نفسها من المحاسبة على ما فعلته في الماضي!
لكن هناك، في المقابل، فئة أوسع تدافع بشراسة عن كل ما يجري، حتى وإن نضحت التفاصيل بالأخطاء. هذه المجموعة تفعل ما تفعل بدافع الخوف من الفوضى وتكرار المأساة. فهؤلاء يرون في أي خطاب نقدي دعوة للعودة إلى الصراع، أو زعزعة للاستقرار. وهم يعانون من إرهاقٍ جماعي، يدفعهم إلى القبول بالنظام الجديد باعتباره “أفضل الممكن”، وأن لا فائدة تُرجى من توجيه الانتقادات له، ما دام قد حاز اعترافًا نسبيًا عربيًا ودوليًا. ويرون أنه لن يتغير، بل سيُكرّس سلوكياته القمعية تدريجيًا، وأن على الناس القبول به، وبالتالي لا ينبغي السماح لأحد بانتقاده، بل يجب قمع كل من يجرؤ على ذلك!
وهناك أيضًا شريحة واسعة تهاجم المنتقدين بدافع الاصطفاف الأيديولوجي أو الطائفي، فـ”تُبحبش” في خلفياتهم لتتّهمهم بأنهم من الأقليات الحاقدة على “سلطة السنّة المستعادة”!
كما توجد فئة تستفيد ماديًا أو سياسيًا من النظام الجديد، كما استفادت من سابقه، وترى أن من ضرورات الدفاع عن مصالحها، امتشاق السيف والطعن في كل ما يُكتب، وتهديد كاتبيه بالعقاب الشديد!
وفي النهاية، يبقى من بين المدافعين الشرسين عن الدولة الجديدة وحكومتها، أولئك الذين يتبنون سردية “النصر”، ويشعرون بأن التفاوت بين صورته الجذابة والواقع الملموس هو “الخذلان” الذي لا يجرؤون على التصريح به. فيمضون، وهم يقمعون المعترضين، في صياغة سردية نصر مشوّهة، لأن الاعتراف بالإخفاق مؤلم نفسيًا، ويُحطمهم بعد أن رفعوا سقف توقعاتهم بعد انتصار 08/12/2024.
المقارنة بين ما كان يجري في زمن الأسد قبل الثورة، وما جرى خلالها، وبين ما يحدث الآن، من حيث الانتقادات وردود الأفعال عليها، تُظهر أن الحساسيات لم تعد أمنية بالضرورة، بل أصبحت تُبنى على ردود فعل شعبية “تطوعية”. فهؤلاء الذين يهاجمون المنتقدين ليسوا منظمين، ولا يتبعون فرعًا أمنيًا أو جيشًا إلكترونيًا، بل هم جحفل من الخائفين، لا يدركون أنهم من خلال ممارساتهم الرائجة حاليًا، يعيدون إنتاج القمع الذاتي، ويُساهمون في تشويه صورة السلطة أمام أي مراقب خارجي، في الوقت الذي تحاول فيه هذه السلطة إقناع السوريين والعالم بأنها ستقود البلاد بعد نيل الحرية نحو الخير والرخاء!
تلفزيون سوريا
——————————-
دمشق المنقسمة على نفسها وفتاوى الحشمة المستجدة/ سميرة المسالمة
18 أبريل 2025
دمشق التي تصحو على تعب وتنام على أهزوجة، هي مدينة تنقسم بين ليلها ونهارها، بين جدها ولهوها، فدمشق الصباح لا تحتاج إلى جوازات سفر لتعرف أنك قادم من بلاد الهجرة واللجوء، فسكانها الذين يتجولون فيها في طرقاتهم إلى العمل يختلفون عنك في كل شيء، في قسمات الوجه المتعبة الباحثة عن مصدر رزق، وفي ثياب مرت عليها سنوات عجاف، وتعابير الوجه المبهمة بين الفرح بزوال ذلك النظام الحاقد على إنسانيتهم، وبين الهم الحائر المزروع في نظراتهم عن مصير لقمة العيش المفقودة في بلد شبه مدمر ونصف محترق وبقية تستنهض نفسها في محاولة لنزع قيد الموت من على رقبتها.
أما دمشق المساء فتلك سورية الغائبة عن معالم الحرب، وفصول الجفاف، تعيش بين أزقة حافلة بالأنوار وضجيج الصحون والابتسامات المرسومة غصبًا على وجوه (النُدُل) من فقراء النهار، ناشطو العتمة المضاءة غير أولئك الذين لا يعرفونها إلا بقصد الخدمة والعمل، سيارات فارهة تمر بجانبك، لا يقلقها ضيق المساحات، ولا يحد من سرعتها قلق الضحايا على الطرقات، شيء من رفاهية مصطنعة، وآخر من فرحة العودة إلى وطن مسروق، تتفهم الحال الثانية أنها غدق من كرم الزوار على أهاليهم، في حين ترى المتعالين من أثرياء الحرب يحتلون أماكنهم المعتادة، كأنهم خلعوا ثوب النظام وارتدوا حلة الحاضر، لا تزال أقنعتهم صالحة لم يستهلكها الزمن بعد، ولا تزال دمشق الليلية خاصتهم التي أنهكت دمشق الصباح.
الطبقة الوسطى التي أمعن نظام الأسدين في تذويبها وصمدت خلال عقود ستة، كانت تتحداه وتواجهه بالعلم والمعرفة والثقافة، أعلنت على ما يبدو خلال الحرب الدامية استسلامها، أخذت مع معظم الشعب مكانها بين الفقراء، وحملت كتبها وفلسفتها وأشعارها وتقوقعت في بيوتها شبه المتهاوية، يصعب ترميمها، ويصعب هجرها، شاخت كما كل أبنية العاصمة، مع فارق كبير فحيث لا تزال رائحة عبق النظافة طاغية عليها.
صارت مؤسسات الدولة ووزاراتها شبه عاجزة عن حمل أعمدتها، غيَّب حقد الأسد على تراث السوريين هيبة الأماكن، أمعن في تعذيبها كأنه ينتقم من تاريخها، تواسيها المارة الجدد بالوقوف عندها، وبالصور في ساحاتها، وعلى أسوارها، بزيارتها التي تؤكد قدسيتها في النفوس، تتعثر كلمات المواساة، ولكننا نعلم أن حجم الخراب أكبر من أن ترممه عبارات العزاء.
دمشق الواقع أجمل بكثير من توصيفات أو “بوستات” الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، تلك التي تتباكى على مرحلة الأسد، وتؤلف الحكايات عن أسلمة البلد، بينما لم أشعر خلال تجوالي بكثير من أحيائها (حسب ضرورات حركتي) بتلك الصحوة التي تجلد النساء على سفورها، أو تحدد ألوان ملابسهن وطرائق مشيتهن، لكن ذلك لا ينفي وجود من يحاول تعكير صفو سكينتنا، والتدخل في شؤوننا، وتجريمنا والوصاية علينا.
المحزن في الأمر أن ادعاء المعرفة في شؤون الدين والدنيا صار مهنة من لا مهنة لهم، لا يقتصر الأمر على الرجال فقد شاركت نساء حملاتهم، تارة بالوعظ المقبول لغة، وتارة باستنهاض همم الرجال للبحث عن فتاوى التكفير لمن تخالفهن الرؤيا والرغبة، فشاعت الفتاوى الشعبوية تحت مسميات الحرية الفكرية، وبعضهن دخلن في تمييز الألوان فبعضها صالح للمسلمات، وبعضها تبرج الكافرات، مهددات بنار تحرق وحرمان من جنة لا تحل لهن.
فهذه حال نسوة ترغبن في تغييب أدوارنا، وتمنعن على النساء حرية الاختيار، بل إحداهن كتبت صراحة في اعتراض غير مبرر بل ويدعو إلى الفتنة والتحريض على إطلالة للسيدة الأولى (لطيفة الدروبي) زوجة الرئيس أحمد الشرع التي وعلى الرغم من أنها لا تزال على حشمتها وأدب تعاملها، ومثلت موقعها كما يجب ونحب، وتعاطت مع مضيفتها السيدة أمينة عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفق متطلبات زيارتها، متسائلة بقدر من التجني (هل مقبول هذا التنازل بالستر والحشمة؟) والصحيح أن نسألها هل مقبول هذا التطاول على سيدة حرة بهذا المنشور وبتلك الجرأة؟
بعض الانتقادات بحدتها، تشعرك أن سورية الحاضر غابت عن سورية الحضارة، وأن معايير التقييم الإسلامي تحددها ناشطات وناشطو فيسبوك وإكس وغيرهما، حسب ما تمليه معارفهم قليلها ومحدوديتها، ولهذا من الضرورة اليوم ألا يرى الناس مدنهم عبر عيون من يحبها بلا حدود، أو متأزم منها بلا حدود، فلا من يغطي على مثالبها يستطيع أن يمحوها من واقعها، ولا من يراهن على رسمها بعين كارهة وقلب حاقد يستطيع أن ينتزعها من قلوب محبيها، فدمشق على رحابتها تسكن قلوب من يعرف قدرها وقيمتها.
* كاتبة سورية.
ضفة ثالثة
——————————
سلاف فواخرجي والأسد/ زياد بركات
21 ابريل 2025
لماذا يُعجب دونالد ترامب بفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون؟ أو يُعجب الضحايا بجلاديهم أحياناً، في لاوعيهم على الأقل؟ أسئلة مثل هذه وغيرها تطرح نفسها في حالة الفنانة سلاف فواخرجي وهي ممثلة بالغة الجمال، على موهبة متواضعة بالمقارنة مع مواهب سورية أخرى عظيمة في الدراما والسينما.
لم تكفّ سلاف فواخرجي منذ سقوط الأسد عن الدفاع عنه. أمَا كان بإمكانها أن تصمت من أجل مشاعر الضحايا على الأقل؟ بلى، أن “تكوّع” بتعبير السوريين؟ نعم، ولكنّها لم تفعل، وإذا سُئلت أجابت ودافعت عن رئيسها الفارّ الذي قمع الثورة الشعبية عليه بأفدح أثمان يمكن أن يتكبدها شعب في العالم؛ فلماذا لم تصمت وكثيرون استفادوا من النظام أكثر منها لكنّهم صمتوا؟ وثمة مَن “كوّع” ونأى بنفسه تماماً عن الأسدَين (الأب والابن)، ولم يعدم مبرّرات حتى لو كانت مختلقة، كما فعل دريد لحّام وهو من رموز الدراما السورية التي كان صعودها مثيراً للإعجاب، فما أسوأ من محاولات بعض الناس سلب الآخرين كلّ فضيلة محتملة لأننا نختلف معهم.
تحدثت سلاف فواخرجي عن رجل مهذّب وشريف اسمه بشار الأسد، جعلها تتقدّمه عندما دخلت مكتبه وقابلته. ورجل كهذا كما ترغب في بناء صورته لا يمكنه أن يقتل، فمن فعل ذلك رجالاته، وهو يُلام على ذلك ليس أكثر، كما أنه لم يقمع ويرتكب المجازر، فثمة ما هو ملفّق ضده، إذ لا يمكن لرجل مهذّب أن يفعل كل هذا.
هذا من ميكانيزمات الدفاع عن النفس، فأنت لم تخطئ عندما دافعت عن رجل هذه صفاته، ولو كانت غير ذلك كما يقول أعداؤه، وهم الشعب بالمناسبة، فهذا يعني أنك مخطئ مثله، ومتواطئ، وانتهازيّ رخيص، وبلا أي مرجعيات أخلاقية، وفي الحال هذه عليك أن تدافع عنه لـ”تبييض” صورتك أنت لا صورته، ولتذهب الحقيقية إلى الجحيم.
كان هتلر، وفق مؤرخيه، بالغ التهذيب، ذوّاقة رفيع المستوى للموسيقى والفنون، بل إنه ترك خلفه بعض اللوحات التي رسمها بنفسه، ثم إنه كان محباً، وعاشقاً بالغ الرقة، وتزوّج عشيقته إيفا براون قبل أن ينتحرا معاً. ولو بقيت إيفا براون على قيد الحياة وسئلت عنه لتحدثت عن العاشق، والمُحبّ، وصاحب النزوع إلى الفنون، ولما رأت غير ذلك من الصورة التي كانت بالغة القتامة في تاريخ بلاده والإنسانية.
حدثني صديق قابل الأسد عن دماثة الرجل وتواضعه، عن إصغائه لساعات لمحدّثه، ولطفه البالغ في الجلوس إلى جوار ضيفه وتقديم الضيافة المتقشفة له، ثم اصطحابه بعد اللقاء إلى البوابة الخارجية، ومصافحته له وتمنيه ألّا يتردد في زيارته كلما قصد دمشق.
لا صديق كاتب هذا المقال جانب الصواب في انطباعاته، ولا إيفا براون لو فعلت، لكنْ هذا جزءٌ صغير جداً من الصورة التي تكشف تناقضات الإنسان، إذ ثمة قرود وضباع وكواسر وآكلو لحوم في ذلك البناء الصغير الذي يمشي على قدمين ونظنه ملاكاً في طفولته.
في بدايات الثورة على الأسد، كتب مراسل وكالة رويترز في عمّان مقالاً عن احتجازه لفترة قصيرة في دمشق. تحدث فيه عن ضابط يتحدث بغلظة، وعن أصوات موقوفين غير بعيدين عنه لا تُحتمل، وعن الضابط نفسه الذي تصله مكالمة هاتفية في ذلك الوقت فيجيب برقة بالغة وهو يتحدث مع أفراد أسرته. كيف فعل كل هذه الأشياء معاً؟ أنت لا تعرف، ولك أن تتخيّل زائراً للرجل كان يمكن أن يُحال إلى تحقيق تحت الضرب، فإذا به يُفاجأ بالضابط نفسه وهو يعرض عليه تناول القهوة معاً، ويعتذر منه عن إحضاره بالخطأ، ثم يوصله بنفسه إلى البوابة الخارجية للمسلخ، فماذا سيكون انطباعه عن ذلك الضابط الرقيق الذي أسهب في شرح المعادلة المعقدة التي يعاينها وزملاؤه في الفرع الأمني، فهم يحاربون الإرهاب وليس أنت القادم بالخطأ إلى المقر الأسوأ في انتزاع الاعترافات في العالم.
هذه ليست عقدة استوكهولم، بل أسوأ. إنكارٌ متطرّف للأسوأ لأننا نجونا من السيئ.
في “البريء” لعاطف الطيب (إنتاج 1986) يظهر الضابط (محمود عبد العزيز) أباً وزوجاً طيباً في بداية الفيلم، وأنت لن تصدّق أبداً أنه الضابط السادي نفسه الذي يستمتع بتعذيب السجناء السياسيين في السجن الصحراوي. كان على سلاف فواخرجي أن تفتح عينيها وترى.
العربي الجديد
—————————
حزب الله منتظراً على شرفة المفاوضات الأميركية – الإيرانية/ صهيب جوهر
2025.04.21
تراقب الأطراف الإقليمية والدولية التركيز اللبناني والأميركي الجاري في ملف سلاح حزب الله والحديث المستمر عن سحبه، وخاصة مع توافد المبعوثين الأجانب الى بيروت، وكان آخرها نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي حملت في جعبتها رسائل واضحة عن حزب الله وسلاحه، باعتباره وفق قولها “سرطان ينخر الجسد اللبناني”.
تراقب الأطراف الإقليمية والدولية التركيز اللبناني والأميركي الجاري في ملف سلاح حزب الله والحديث المستمر عن سحبه، وخاصة مع توافد المبعوثين الأجانب الى بيروت، وكان آخرها نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي حملت في جعبتها رسائل واضحة عن حزب الله وسلاحه، باعتباره وفق قولها “سرطان ينخر الجسد اللبناني”.
وبعيداً عن التحريض السياسي الحاصل بين حزب الله وخصومه في لبنان، والدخول في زواريب التنازع على المواقع السياسية، إلا أن الثابت في كل هذه المشهدية، هو التحولات الحاصلة في المنطقة، وخاصة في ظل المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي التقطها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بحديثه عن الحوار الثنائي بين الرئاسة اللبنانية من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، وخاصة أن النقاش الجاري مؤخراً عن تنازلات ستقدمها ايران في ساحات نفوذها السابقة تفتح الباب على دفع حزب الله للقبول بالوقائع التي أفرزتها الحرب من جهة، وسقوط نظام الأسد من جهة أخرى.
ولبنان الموضوع على لائحة اختبار دولية وإقليمية، دفع عون للحديث عن إمكانية استيعاب الجيش لعناصر حزب الله، لكن ليس عبر استنساخ تجربة الحشد الشعبي في العراق، وذلك قبيل زيارته التاريخية لدولة قطر، لأن الدخول في هكذا حسابات تحتاج لكثير من الدقة لحماية السلم الداخلي وخاصة أن التأثيرات السياسية والأمنية ما بعد الحرب لاتزال مؤثرة على الواقع الداخلي، على الرغم من كل المحاولات الحاصلة لإعادة تكوين السلطة وبناء الدولة.
لكن حزب الله بدأ الحديث عن مستلزمات للحوار على السلاح والانخراط في استراتيجية أمن وطني، معتبراً أن الممر الإلزامي لهكذا حوار يسلتزم انسحاباً إسرائيلياً من جميع الأراضي اللبنانية ومنع الخروقات والاغتيالات وتحريك ملف إعادة الإعمار، وهو بدوره سيبدي وفق ما يوحي إيجابية في سلاحه وسلاح المجموعات الأخرى، فلسطينية كانت أم لبنانية.
وهو ما يعني أن الحوار حول السلاح سيدخل في متاهات متشعبة، وخاصة أن الحزب يعول دائماً على يأس خصومه ومحاوريه المحليين أم الدوليين، وهذا السياق سيكشف ما سينتج من المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي ستكون حاسمة وستلامس النفوذ الإقليمي لإيران ومن ضمنه التركيبة العسكرية لحزب الله في لبنان، وجهازي الأمن والعسكر.
بالمقابل فإن الجانب الأميركي ينقل رسائل متعددة حول هذا الأمر، وخاصة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقل عن ترمب للوفد الإيراني وجود مهلة زمنية لإنجاز المفاوضات مع إيران لا تتعدى الثلاثة أشهر. ما يعني أن مهلة واشنطن لإيران تشمل حزب الله في لبنان، أي نهاية الصيف المقبل.
من هذا المنطلق بدا مرشد الثورة علي خامنئي يحاول الإيحاء بأنه يدير بشكل شخصي ومباشر ملف المفاوضات، وتصريح خامنئي أن المراحل الأولى من المحادثات سارت بنحو جيد، يمكن تفسيره بأنه إشارة على لمساته المباشرة على هذه المفاوضات. وهي نقطة يضيفها المتحمسون في إدارة ترمب على رؤيتهم لمسار المفاوضات والتي تدفعه إلى الاستنتاج بأن ظروف إيران السياسية تجعلها ملزمة بالتجاوب مع إدارة ترمب واعتماد الرضوخ الاضطراري للتوصل إلى اتفاق هي بأمس الحاجة إليها.
لكن الفريق المتأثر باللوبي الإسرائيلي في واشنطن لايزال يشكك بفرضية الوصول لاتفاق جدي مع إيران، وهو باشر بحملة تشكيك داخلية حيال جدية نية الحرس الثوري الإيراني والمرشد من عقد صفقة مع واشنطن، وخاصة أن كل التجارب السابقة مع طهران تشي بأنها تعتمد على مبدأ إهدار الوقت لإغراق المفاوضات بتفاصيل شائكة بهدف إمرار المرحلة وانتظار ظهور مشكلات داخلية أو دولية أمام ترمب ونتنياهو، وبالتالي اضطراره إلى وضع ملف إيران جانباً والتفرغ لملفات تشغل الداخل الأميركي أكثر.
لذلك عمدت القيادة العسكرية الأميركية إلى إرسال العديد من القطع العسكرية البحرية إلى الشرق الأوسط، تحسباً لتطورات غير متوقعة، إضافة لنقل قنابل ذكية جديدة لإسرائيل، وهي مؤشرات واضحة إلى أن الخيار العسكري هو وارد بشكل أساسي، لأنه ورغم كل الأجواء الإيجابية التي سادت عقب جولة السبت الماضي إلا أن نسبة الفشل لاتزال مرتفعة، وهو ما يعني أن كل الاحتمالات ستبقى واردة في المستقبل.
والأكيد أن الجولة التفاوضية الثانية غداً، قد تنتقل من المشروع النووي الى ملف الصواريخ الباليستية وساحات الوجود الإقليمي، وهو الشق المرتبط بلبنان، وخلال الأيام الماضية سربت طهران تصريحات لرويترز على لسان مصدر في الخارجية أنها لن تتفاوض عن حزب الله والحوثي، وأن على واشنطن أن تندفع للحوار معهم، لكن المعلومة المؤكدة أن إدارة ترمب ستفرض على إيران وقف جميع أشكال الدعم لحزب الله والحوثي وجماعات عراقية على مستويات مالية وعسكرية، ما يعني إضعافاً مباشراً لهذه المجموعات مهما بلغ حجمها السياسي على اعتبار أن الملف هو المرتكز الرئيسي للتأثير السياسي في لبنان.
وعليه يمكن استنتاج أن كل التوجه الأميركي الجديد في المنطقة يسعى لحسم الأمور مع خصومها، والتفاهم على ملأ فراغها مع حلفاءها، وهي اليوم تبحث على سبيل المثال عن حلول تمنع أي مواجهة عسكرية بين أنقرة وتل أبيب، في موازاة حماية الأطراف العربية المتعاونة معها ومنع انهيارها، كما هي الحال في الأردن ولبنان، وذلك في انتظار فهم الخريطة الجديدة التي تريدها لسوريا ومستقبل إيران، بعد تدمير أذرعها عن المشهد السياسي والتي صنعت الصورة السابقة للمنطقة
تلفزيون سوريا
————————————————
اللامركزية في سوريا.. حل تحمله الثورة أم فخ تفرضه الفوضى؟/ باسل المحمد
2025.04.21
مع دخول سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد، طفت على السطح عشرات الرؤى حول مستقبل الحكم في البلاد، من قبل بعض سلطات الأمر الواقع التي كانت تمارس هذا النوع من الحكم قبل سقوط النظام، مثل “قوات سوريا الديمقراطية” التي تطالب بحكم ذاتي موسّع ضمن إطار لامركزي.
وبينما ترى بعض القوى أن اللامركزية قد تكون مدخلًا لبناء دولة عادلة ومتوازنة، بعد عقود من الحكم المركزي المستبد، يحذر آخرون من أن تطبيق هذا النموذج في ظل الانقسامات الجغرافية والسياسية الحالية قد يعمّق التفتت ويهدد وحدة البلاد.
بالمقابل، تشير العديد من التجارب الإقليمية والدولية إلى أن اللامركزية ليست مجرد خيار إداري، بل مشروع سياسي واجتماعي عميق، يتطلب بيئة مستقرة، وثقافة سياسية ناضجة، وتوافقات وطنية شاملة. فهل سوريا اليوم، بعد كل ما مرّت به، جاهزة لمثل هذا التحول؟ أم أن الحديث عن اللامركزية في ظل هذا التفكك قد يفتح أبوابًا لمزيد من التشظي والانقسام؟
ليست طرحًا جديدًا
لم تكن “اللامركزية” فكرة طارئة على المجتمع السوري بعد سقوط نظام الأسد، فمع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، برزت مجموعة واسعة من المجالس المحلية واللجان المدنية التي أدارت شؤون المدن والقرى في المناطق المحررة، بعيدًا عن مركزية دمشق.
هذه الهياكل، التي بدأت كآليات طوارئ وتنظيم ذاتي لمواجهة الفراغ الأمني والخدمي، تطورت مع مرور السنوات، ونتيجة لظروف سياسية وعسكرية متداخلة، أدت إلى تشكّل أربع سلطات أمر واقع، فرضت نفسها خلال سنوات الحرب، ونجحت إلى حد كبير في إدارة شؤونها المحلية من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
كل من هذه النماذج حمل بصمته الخاصة: ففي شمالي وشرقي سوريا، أسّست “قسد” نظامًا كانتونيًا يعتمد على انتخابات مباشرة ولجان متخصصة لإدارة التعليم والصحة والدفاع الذاتي؛ بينما شهدت إدلب والشمال السوري ولادة حكومتين مصغرتين تُعنيان بالداخلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، مع مجالس محلية منتخبة تعكس تنوع المشهد الثوري؛ وفي السويداء، أثبتت اللجان الشعبية الدرزية قدرتها على تنظيم الأسواق، وتوزيع المواد الإغاثية، وتأمين الحماية الذاتية لأبناء المدينة.
وفي هذا السياق، تشير كثير من الدراسات والتقارير إلى أن هذه النماذج، رغم تفاوتها في التنظيم والتمويل، أثبتت قدرة المجتمع السوري المتنوع على خلق هندسة حكم لا مركزية تحت ضغط الحرب، ما يمهّد اليوم لنقاش جدي حول تحويل هذه “التجارب المؤقتة” إلى مؤسسات دائمة في سوريا ما بعد النظام.
اللامركزية كضرورة
يرى كثير من المطالبين بضرورة تطبيق اللامركزية في سوريا بعد سقوط النظام أن التركيز على نموذج حكم موحّد من دمشق لم يعد يلبّي احتياجات المجتمع السوري وتنوعه، بل قد يزيد خطر تكرار الفراغ الأمني والخدمي الذي انبثق عن النظام المركزي القمعي أيام حكم النظام البائد.
ويستدل الباحثون على ذلك بتجارب الدول التي شهدت تحولات في نظام الحكم، إذ أوضحت أن توزيع السلطات بين المركز والولايات أو المحافظات يساهم في بناء ثقة المواطنين، ويعزز من قدرتهم على المشاركة في صنع القرار، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي على حدّ سواء.
وفي هذا السياق، يرى الباحث الأول في مركز عمران للدراسات، أيمن دسوقي، أن الأنماط الحوكمية المتعددة التي نشأت أيام الثورة، والقائمة على هياكل سلطة وترتيبات مؤسسات مدعّمة باقتصاد سياسي، ما تزال قائمة رغم سقوط نظام الأسد، ولا يمكن أن تتلاشى بسرعة.
وما يدفع باتجاه ضرورة تبنّي نموذج لامركزي، بحسب حديث دسوقي لموقع تلفزيون سوريا، أن مؤسسات الدولة المركزية تعاني من ضعف في القدرات والموارد والإمكانيات، إضافة إلى محدودية في انتشارها الجغرافي، وهو ما يتطلب ترتيبات مجتمعية ومؤسساتية وقانونية واقتصادية لإعادة تنشيطها على كافة الأراضي السورية.
وبالتالي ـ يضيف دسوقي ـ انطلاقًا مما سبق، يمكن القول بضرورة تجاوز النهج المركزي في الحوكمة، لكوارثه الماضية ومحدودية إعادة تأسيسه مجددًا.
إزاء ذلك، نبّه معهد واشنطن للدراسات إلى ضرورة اختيار الفيدرالية كمسار أنسب لإعادة إعمار البلاد، وتجنّب تكرار أخطاء النظام السابق. ورجّح في تقرير أعدّه الأستاذ المشارك مدير الأبحاث في جامعة ليون، فابريس بالونش، أنه “إذا أراد الشرع عدم تكرار أخطاء الأسد، فقد يضطر إلى اللامركزية الحقيقية للسلطة، وإقامة نظام فيدرالي، رغم أن هذا قد يثير أسئلة حول تخصيص الموارد”.
وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد “قسد”، في 10 آذار، والذي نصّ على دمج مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية، إلا أن الإدارة الذاتية ما تزال تؤكد أن “النظام الاتحادي هو المدخل لتسوية سياسية دائمة، يُنهي مركزية القرار، ويمنح المجتمعات المحلية أدوات حقيقية في إدارة شؤونها”، وذلك بحسب تصريحات إلهام أحمد في مؤتمر السليمانية، 17 نيسان الجاري.
مخاطر وتحديات
بمقابل الدعوات التي تطالب بتطبيق اللامركزية باعتبارها حلًا مناسبًا لـ”سوريا الجديدة”، نجد في الطرف المقابل أصواتًا تحذّر من أن اعتماد مبدأ اللامركزية في الحكم، في ظل الظروف التي عاشتها وتعيشها سوريا حاليًا، قد يؤدي إلى صراعات محلية ونزاعات على السلطة، وتفاقم التوترات الطائفية والعرقية القائمة، إضافة إلى احتمال تفكك البلاد وإضعاف الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق، يوضح مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة، أحمد قربي، أن عدم وجود هوية وطنية جامعة يؤمن بها جميع السوريين، بسبب حالات الانقسام الجغرافي والعرقي والطائفي التي سبّبتها الحرب السورية، يُعد من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية في سوريا.
ومن التحديات أيضًا، يتابع قربي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، عدم وجود بُنى قانونية وإدارية قوية تكون مهيأة لتطبيق هذا النموذج في سوريا، التي أُديرت عبر تاريخها بطريقة مركزية شديدة.
ويشرح قربي هذا الجانب بالقول: إنه في ظل عدم وجود جيش قوي، وجهاز أمني متمكّن، وحالة الترهل والضعف في مؤسسات الدولة، فإن تطبيق اللامركزية سيؤدي إلى تفوق الأطراف على المركز، ما يعني الذهاب عمليًا باتجاه التقسيم، كما جرى في العراق على سبيل المثال.
من ناحية أخرى، قد يساهم تطبيق نموذج اللامركزية، من حيث المبدأ، بدعم وتمكين مؤسسات الدولة وليس السلطة، لكن خطورته تكمن في تعدد القوى العسكرية والأمنية على الجغرافيا السورية في الوقت الراهن، والتي من الممكن أن تكون حاملًا محتمَلًا لتنفيذ انقلاب عسكري أو فرض واقع انفصالي في أي وقت، وذلك بحسب الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، عمار فرهود.
وفي الحديث عن تجارب الدول التي نجحت فيها اللامركزية السياسية أو “الفيدرالية”، مثل ألمانيا وسويسرا والهند، يرى مختصون أن تطبيق ذلك في الحالة السورية يواجه عقبات كبيرة، يعود جزء منها إلى التباين الحاد في البنية الديمغرافية وتوزيع الموارد؛ ففي حين تتمتع مناطق شمال شرقي سوريا بثروات طبيعية كبيرة من النفط والزراعة، فإن مناطق أخرى تعاني من هشاشة اقتصادية وافتقار للبنية التحتية، ما يجعل الحديث عن توزيع عادل للسلطة والثروة أمرًا بالغ الحساسية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أعلن معارضته للنظام الاتحادي، خلال مقابلة مع صحيفة “الإيكونوميست” في كانون الثاني الماضي، معتبرًا أنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصبّ في مصلحة سوريا، بحسب تعبيره.
ويُشار إلى أننا هنا لم نتحدث عن العامل الخارجي والإقليمي الذي يعارض هذه الخطوة، وعلى رأسه تركيا، التي تعتبر وجود كيان انفصالي كردي على حدودها الجنوبية تهديدًا لأمنها القومي.
هل من بديل؟
لا يرغب قسم كبير من السوريين بالعودة إلى الحكم المركزي الشديد، الذي عانوا بسببه عقودًا من التهميش والإقصاء في زمن الأسد (الأب والابن). وما زاد في الدفع بهذا الاتجاه هي تجارب الحكم المحلي التي عاشوها خلال سنوات الثورة، والتي أثبتت أنهم قادرون على إدارة مناطقهم رغم الصعوبات والتحديات.
بالمقابل، هناك مخاوف كبيرة لدى القسم الآخر من مخاطر تطبيق اللامركزية في هذا التوقيت، لاعتبارات أمنية متعلقة بوحدة البلاد. لذا، يرى باحثون أن ما تحتاجه سوريا ليس حكمًا مركزيًا شديد التركيز، بل نموذجًا يسمح بالمشاركة الواسعة للمجتمع والمؤسسات المحلية في اتخاذ القرار؛ وهو ما يُعرف بـ”اللامركزية الإدارية”.
وتعليقًا على ما سبق، يقول الباحث فرهود: عندما نضع قواعد الدولة القوية التي تكون فيها السلطة خادمة للشعب، والشعب خادمًا للدولة التي تحمي الجميع، سنصل وقتها إلى قناعة بأن مشاريع الانفصال المستترة بدعاوى اللامركزية، أو مشاريع الدكتاتورية المستترة بضرورة المرحلة، ستسقط أمام الدولة القوية ومؤسساتها المتماسكة؛ لأنها هي الضامن الحقيقي لمكتسبات الثورة ومنجزاتها، وهي الصخرة التي ستتكسر عليها دعاوى تفتيت الدولة أو اختطافها.
أما الباحث أيمن دسوقي، فينوه إلى ضرورة أن تكون المقاربة البديلة ناتجة عن حوار سوري-سوري، وهنا يمكن الاتكاء على الترتيبات الانتقالية التي عقدتها الإدارة السورية الجديدة مع الإدارة الذاتية وبعض المكونات السورية، لما تضمنته، بشكل ما، من إعادة النظر في توزيع الصلاحيات والوظائف، وضمان التمثيل المجتمعي.
ويدعو دسوقي إلى التأسيس لإطار حكم واقعي مرن لإعادة توزيع الصلاحيات والوظائف وتقديم الخدمات بين المركز والأطراف، بحيث يمتلك هذا الإطار قدرة على الحد من عودة الاستبداد مجددًا، عبر معالجة قضايا التمثيل المجتمعي وتوفير ضمانات مؤسساتية.
ولطالما أكدت الإدارة السورية الجديدة على ضرورة إشراك الجميع في العملية السياسية والإدارية، إذ تضمّن الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد “قسد”، على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغضّ النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
كما تضمنت مخرجات الحوار الوطني نصوصًا تؤكد على تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك.
تلفزيون سوريا
——————————————
ما مصير “الحكومة المؤقتة” بعد تشكيل حكومة مركزية جديدة في سوريا؟/ سامر العاني
2025.04.21
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، وتشكيل حكومة سورية جديدة في دمشق، تواصل الحكومة السورية المؤقتة، التي تتخذ من مدينة غازي عنتاب التركية مقراً لها، ممارسة مهامها الإدارية وسط واقع جديد يتطلب تكيّفاً سياسياً ومؤسسياً.
ورغم ما تردد عن إنهاء الحكومة المؤقتة خدمات أكثر من 90 في المئة من موظفيها، إلا أن مصدراً مطلعاً أفاد لموقع “تلفزيون سوريا” بأن هذه النسبة غير دقيقة، موضحاً أن عدد موظفي الحكومة بلغ نحو 300 موظف قبل سقوط النظام، وما يزال نحو 150 منهم على رأس عملهم، ما يشير إلى أن نسبة من غادروا مواقعهم لا تتجاوز 50 في المئة، وغالبيتهم من المتعاقدين المؤقتين داخل سوريا.
وأكد المصدر أن الحكومة المؤقتة ما تزال تحتفظ بأصولها الإدارية في مدينة الراعي، بما في ذلك مقار الرئاسة والأمانة العامة وبعض السيارات التابعة لها، وتواصل العمل في بعض الوزارات، فضلاً عن استمرار العقود مع شركات إنشائية محلية، مثل شركة “كورت” المختصة في تعبيد الطرق، والتي وقعت معها عقداً بقيمة 278,600 دولار أميركي في شباط الماضي.
كما أشار المصدر إلى استمرار عمل مؤسسات خدمية، كمؤسسة الحبوب، ومؤسسة إكثار البذار، ومركز التصوير الطبقي المحوري، ما يسهم في تأمين موارد إضافية لصندوق الحكومة، ويدل على استمرار بعض مظاهر الأداء المؤسساتي.
في ظل هذه المعطيات، تظهر تساؤلات حول مصير الحكومة المؤقتة في المرحلة المقبلة، ومدى مواءمتها مع المتغيرات السياسية في البلاد، لا سيما مع ظهور حكومة جديدة تتولى حالياً مهام إدارة الدولة. وتدور التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة المؤقتة تتجه للبقاء كإدارة محلية انتقالية، أم أنها تمهّد لتسليم الملفات إلى السلطة الجديدة.
تحديات مؤسسية وتنظيمية
تنص المادة 27 من النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن الحكومة المؤقتة تتبع للائتلاف وتُناط بها إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. إلا أن هذا الإطار المؤسسي شهد بعض الالتباسات مؤخراً، مع إعلان المجلس التركماني السوري، الذي يرأسه فعلياً رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى، انسحابه من الائتلاف، في حين استمر مصطفى في رئاسة الحكومة، مما أثار نقاشات حول شرعية الإطار السياسي الذي تستند إليه الحكومة.
تفاقم هذا الجدل خلال لقاء جمع الائتلاف بالرئيس أحمد الشرع، حيث غاب رئيس الحكومة المؤقتة عن الاجتماع، قبل أن يسعى لاحقاً إلى لقاء منفصل مع الرئيس، أفضى إلى طلبه تشكيل لجنة لتسلّم الحكومة، بحسب ما أشار إليه في تصريحات لاحقة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المسار يتطلب توافقاً أوسع ضمن الإطار الذي تأسست فيه الحكومة، ويستدعي تنسيقاً مع الائتلاف لضمان انتقال مسؤول ومنظّم للملفات.
لا تزال تركيا تحتضن مقر الحكومة المؤقتة، وتتعامل معها بعض مؤسساتها الرسمية، ما يعكس استمرار مستوى معين من العلاقة بين الطرفين، رغم ما يبدو من تطور في العلاقة بين أنقرة والحكومة السورية الجديدة. ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول مستقبل تموضع الحكومة المؤقتة داخل الأراضي التركية، خاصة في حال مضت تركيا نحو تنسيق أوسع مع دمشق.
وأكد مصدر في الحكومة أن العلاقات الدولية ما تزال نشطة، حيث يقوم مسؤول العلاقات الخارجية، ياسر الحجي، بزيارات رسمية إلى الولايات المتحدة، وتُموَّل هذه الزيارات من قبل الحكومة المؤقتة، في إطار الحفاظ على قنوات التواصل مع الأطراف الدولية.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس الحركة الوطنية التركمانية، مصطفى عبدي، أن تقريراً قدمه رئيس الحكومة المؤقتة إلى مؤسسة تركية أدى إلى حرمانه وآخرين من إذن العبور إلى سوريا، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولات للحد من التعددية في تمثيل التركمان، وهي نقطة مثار نقاش داخل الأوساط السياسية التركمانية.
يوضح الباحث وائل علوان أن الحكومة الجديدة تعمل حالياً على استلام الملفات الإدارية من المجالس المحلية ومن الحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، خاصة مع وجود تحديات ميدانية مثل استمرار سيطرة “قسد” في مناطق الشمال الشرقي، ووجود مشاريع تنموية جارية في مناطق أخرى.
ويرى علوان أن الهدف العام هو التوجه نحو إدارة موحدة تُشرف عليها الحكومة المركزية، عبر دمج المجالس المحلية في هيكل محافظات جديد، لكنه شدد على أن هذه العملية تحتاج إلى وقت كافٍ لضمان نجاحها.
مشروع مشفى صوران الجامعي
أثيرت مزاعم في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الحكومة المؤقتة بتحويل مبلغ 900 ألف دولار من مخصصات إنشاء مشفى جامعي في صوران إلى بند النفقات التشغيلية. غير أن مصدراً في الحكومة المؤقتة نفى هذه المزاعم، مؤكداً أن التمويل كان من موارد الحكومة الذاتية، وأن المبلغ المتبقي من المشروع هو 400 ألف دولار من أصل كلفة كلية بلغت 650 ألف دولار.
وأشار المصدر إلى أن الأصول المتعلقة بالمشروع ما تزال محفوظة، والمرافق الحكومية العاملة في مناطق الشمال مستمرة في أداء مهامها، فيما لا يُعرف الرصيد النهائي لصندوق الحكومة إلا من قبل رئاسة الحكومة.
تبدو الحكومة المؤقتة اليوم وكأنها تقف بين مرحلتين: ماضٍ أدت فيه دوراً مهماً في إدارة مناطق خارجة عن سلطة النظام، وواقع جديد يشهد بروز حكومة مركزية تسعى لتوحيد الإدارة. ورغم التساؤلات المشروعة حول مستقبل الحكومة المؤقتة، فإن المسار الأمثل يبقى مرهوناً بمدى التنسيق بين مختلف القوى السياسية، وحسن إدارة المرحلة الانتقالية بما يخدم الاستقرار ويوحد الجهود.
————————–
من التجربة السورية.. شيوخ العشائر والسلطة/ عدي محمد الضاهر
2025.04.20
منذ عقود طويلة، شكلت العشائر في سوريا كتلاً اجتماعية ذات نفوذ واضح في المشهد المحلي، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من البلاد، حيث العشيرة ليست مجرد بنية اجتماعية، بل سلطة فعلية تؤثر في القرارات، وتوجّه السلوك، وتتحكم بمصائر آلاف الأفراد. ومع صعود الأنظمة القمعية في سوريا وخصوصاً في ظل نظام الأسد الأب، ثم الابن، لم تكن السلطة لتغفل عن هذه الحقيقة، بل أدركت مبكراً أهمية تطويع شيوخ العشائر وتحويلهم إلى أدوات بيدها، في سبيل ترسيخ سلطتها وتوسيع نفوذها على الأرض.
شيوخ العشائر شركاء في السلطة
أول تقارب تاريخي فعلي بين السلطة المركزية في سوريا وشيوخ العشائر بدأ بشكل واضح خلال عهد حافظ الأسد، وتحديداً في سبعينيات القرن الماضي، بعد استلامه الحكم عام 1970 عبر انقلابه الذي سُمي ب“الحركة التصحيحية” ولكن الجذور الأعمق لهذا التقارب تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي (1920–1946)، حين حاول الفرنسيون استمالة زعماء العشائر في البادية والمناطق الريفية لكسب ولائهم مقابل منحهم بعض الامتيازات والنفوذ المحلي، فكان ذلك أول شكل رسمي لعلاقة سياسية بين السلطة وشيوخ العشائر، وإن كانت على يد قوة أجنبية.
مع تولي البعث للسلطة أدرك حافظ الأسد منذ بدايات حكمه أهمية التغلغل في البنية العشائرية، خاصة مع وجود مؤسسات رسمية ضعيفة خارج مراكز المدن الكبرى. فعمل على استمالة شيوخ العشائر، عبر منحهم الامتيازات، وتعيين بعضهم في مواقع حكومية أو “برلمانية” صورية تخدم مصالح شخصية وتسلطية وبهذا، تحولت الزعامة العشائرية من مسؤولية اجتماعية إلى باب من أبواب الثروة والنفوذ، مقابل الولاء الكامل للسلطة المستبدة.
لم يتغير هذا المشهد كثيراً في عهد بشار الأسد، بل تعمق أكثر، وحين اندلعت الثورة السورية عام 2011، وبدأت آلة القمع تضطهد وتقتل كل من يطالب بالحرية، كان النظام بحاجة إلى واجهات اجتماعية تُضفي شرعية شكلية على تحركاته القمعية، وهنا لعب شيوخ العشائر دوراً بالغ الخطورة: فهم لم يكتفوا بالحياد، بل اصطفّ كثير منهم إلى جانب السلطة، واندفعوا إلى تجييش شباب عشائرهم للدفاع عن النظام وتنفيذ أجندة دول تحمل مخططات عدائية لسوريا وأبنائها ، تحت شعارات كاذبة مثل الاستقرار ومحاربة الإرهاب ومحبة الوطن!
زج الشباب في أتون الموت بدافع النسب والدم
المأساة الكبرى تمثلت في استخدام النظام لهؤلاء الشيوخ كأدوات لتجنيد الشباب عبر الولاء العشائري. فبدلاً من أن يكون الشاب السوري مواطناً له الحق في التفكير والموقف، تحوّل إلى تابع، يُؤمر فيطيع، ويُزج في معركة للدفاع عن المستبدّين، يدفع ثمنها من دمه ومستقبله.
شيوخ العشائر أو من نصّبهم النظام السوري كذلك استخدموا رابطة الدم والنسب للضغط على أبناء عشائرهم، تحت شعار “من يخرج عن قرار العشيرة، يخرج عن شرفها”، وهكذا، وجد آلاف الشباب أنفسهم مجبرين على القتال، لا من أجل وطن، بل من أجل حماية سلطة استبدادية، ودفاعاً عن مصالح مشيخة تحولت إلى شريك في الفساد.
أسوأ ما في الأمر، أن الشيوخ تفردوا بتقرير مصير أبنائهم من دون استشارتهم أو مراعاة لتطلعاتهم. قرارات الحرب والسلم، الولاء والمعارضة، تُتخذ في المجالس العشائرية، لا في النقاشات الحرة وتحولت العشيرة من مظلة حماية إلى سجن اجتماعي، يختطف حرية الفرد ويقمع صوته، بل ويسلبه حياته.
هذا التفرد حمل في جوهره خطراً بالغاً على فكرة المواطنة، إذ يعيد مراراً إنتاج البنية السلطوية ذاتها التي ثار السوريون عليها: سلطة تُدار من فوق، لا تشاور أحداً، وتُقدّم أبناءها قرابين لبقائها، منتجين في ذلك بيئة جاهزة لكل مستبد أو متسلط لتطبيق أفكاره في التسلط والقمع .
التحول من النزعة العشائرية إلى الوطنية
لكي تولد سوريا جديدة، لا يكفي إسقاط النظام السياسي وحده، بل لا بد من تفكيك أدواته الاجتماعية التي أسهمت في ترسيخه، وفي مقدمتها البنية العشائرية حيث تُوظف في غير موضعها. لسنا ضد العشيرة كمكوّن اجتماعي وثقافي، بل ضد توظيفها السياسي الذي يجعل منها خادمة للسلطة بدل أن تكون خادمة لأبنائها.
التحول المطلوب هو من “النزعة العشائرية” إلى “النزعة الوطنية”، حيث يصبح الولاء للوطن لا للشيخ، والانتماء لدولة الحريات لا للعائلة، والقرار جماعياً لا فردياً. بهذا فقط يمكننا أن نضع حداً لثقافة الثأر، والتكتلات المقيتة، والانغلاق الاجتماعي الذي يُستخدم كمطية لقمع الحريات ودعم الطغاة.
العشائرية نعمة في يد السلطة ونقمة على أبنائها
أما بالنسبة للسلطة، فالعشائرية كنز لا يقدر بثمن. فهي تُمكّن النظام السياسي (أي نظام سياسي) من السيطرة على مناطق شاسعة من دون الحاجة إلى مؤسسات حقيقية أو إدارة مدنية فعالة. يكفي أن يُرضي النظام شيخ عشيرة ما، مالاً، أو منصباً، أو وجاهة حتى يضمن ولاء آلاف الأفراد من دون عناء. وهكذا، تتحول العشيرة إلى أداة لضبط الشارع، وقناة لتجنيد المقاتلين، وواجهة اجتماعية تزيف الشرعية.
بشكل عام النظام السياسي عبر تاريخ سورية وخصوصا في حقبة البعث والأسد الأب والابن كان لا يرى في العشائر سوى كتلة قابلة للتطويع، يسهل شراؤها واستخدامها عبر مشايخها، ثم التخلص منها حين تنتفي الحاجة. وقد فعلت الأنظمة ذلك مراراً، حين انقلبت على بعض الشيوخ بعد أن استنزفت دورهم، أو حين تجاهلت تضحيات أبنائهم في سبيل بقائها.
لا سلطة فوق دماء الشعب
إن دماء الشعب السوري التي سالت، لا يجب أن تُنسى أو تُغتفر، ولا يجب أن يُسمح بتكرارها عبر التواطؤ مع أدوات السلطة، مهما لبست من لبوس اجتماعي. فإذا كنا نطمح إلى سوريا عادلة، حرة، مدنية، فعلينا أن نقطع مع أخطاء الماضي، لا أن نُعيد إنتاجها. ومهما كان للسلطة من أدوات، فإنها لا تساوي شيئاً أمام كرامة الإنسان وحريته حيث لا يمكن بناء دولة حديثة ومجتمع عادل في ظل وجود زعامات عشائرية تتصرف كسلطة موازية للدولة، وتختطف قرار الناس باسم النسب والانتماء للعشيرة.
العشائر في أصلها، كانت مجموعات تضامن وتكافل، تُطعم الجائع، وتحمي الضعيف، وتؤوي الغريب وهذا ماتحتاجه سوريا ومخيمات النازحين على الأقل في في أيامنا هذه، أما مانراه في العقود الأخيرة أنها حُرفت عن معناها، وتحولت في كثير من الحالات إلى ديكور فارغ يُستخدم لتجميل وجه السلطة، وواجهة يُستثمر فيها “الزي التقليدي” كأداة نفاق سياسي، لا كرمز كرامة أو هوية، فعندما يرتدي مسؤول في السلطة لباس أحد شيوخ العشائر في مشهد استعراضي، فهو لا يُكرّم التراث، بل يُوظفه لخدمة صورته. وعندما يصفق له بعض الشيوخ ويهدونه سيوفاً أو عباءات، فهم لا يُكرّمون الضيف، بل يطبعون صورة تقديسية للمسؤولين والسلطة على حساب التباهي والتفاخر.
آن الأوان لتفكيك إرث العشيرة السلطوي وإضعاف العصبية القبلية وإعادة رسم صورتها الحقيقية في أذهان العامة آن الأوان لبناء مواطنة حقيقية تُعيد للإنسان السوري صوته، وقراره، ومستقبله.
تلفزيون سوريا
—————————-
دمشق وفرصة تغيير الدلالات السياسية/ أحمد جاسم الحسين
2025.04.20
تحولت دمشق في الشهور الماضية إلى مركز الأخبار الأول في العالم، توافد صحفيون وصناع مواد بصرية ومؤثرون اجتماعيون وسياسيون من كل أنحاء العالم إليها، يريدون اكتشاف أسرار هذه المدينة التي تعبر عن دولة.
كثيرٌ منهم كان سعيداً أنها غدت مدينة ممكنة بعد أن كانت مدينة مستحيلة ممتلئة بالعسس والمخبرين!
السلطات الحالية فتحت كل أبواب دمشق للزيارة، لا مكان ممنوعاً على الصحفيين، بما فيها المعتقلات والسجون وقصر الشعب!
الغائبون السوريون بعد أن عاشوا في مدن كبيرة، تفاجؤوا أنهم بعد أول يوم مشي في دمشق، زاروا معظم أحياء المدينة، كم هي صغيرة المساحة. كانوا يمشون في مدن كبيرة أياماً ولا تنتهي: إسطنبول، القاهرة، برلين، باريس، لندن، دبي!
غير أن دمشق مدينة مكثفة لا يُشبع منها، كل يوم صباحاً يتولد لديك حنين جديد كي تزور حياً زرته البارحة أو قبلها، لا أنت تعرف السر، ولا هي تطلعك على الحكاية، لأنه كل يوم لها دلالات جديدة تتفتح!
أقرأ هذه الأيام أن هناك نية تخطيطية ليغدو اسم دمشق وريفها “إدارياً” دمشق الكبرى، تلك خطوة، على مستوى التخطيط العمراني والبشري، مهمة جداً لنكبّر دمشق جغرافياً وهي الكبيرة الراسخة في قلوبنا دلالياً.
سوريون كثيرون يملؤون يومهم بالصور، يريدون أن يمسكوا بالمدينة، وأن يتأكدوا أنها لن تسيل من أيديهم مرة أخرى، يتعربشون بكل لحظة قبل أن تفلت من جفاف الذاكرة.
يأتي دبلوماسيون من مختلف أنحاء العالم فيحدثهم السوريون عن “شامهم” بلغة عشق حبيبة. يستغرب الدبلوماسيون ذلك، لكنهم حين ينزلون إلى حاراتها ومطاعمها وترحاب أهلها يتسرب إلى أنفسهم شيء من الوقوع في عشق دمشق!
لو تغنينا بالشام سنوات وكتبنا لها مئات النصوص فإننا لا نستطيع أن نعبّر عن ساعة مشي في شوارعها وحوار مع حيطانها.
عندي صديق كان يحب المشي في دمشق ليلاً، في حاراتها القديمة وكنا نظن أنه “مخاوي الليل” لأنه كل مرة كان يحضر لنا عدداً من السرديات عما مر معه!
يقول صديق لم يزر دمشق منذ سنوات طويلة جداً: أبهرتني هذه المدينة رغم أنني كنت أعيش في نيويورك، حيطانها الرمادية المهملة، وجوه البشر التي نسيها الزمن!
صديقة أخرى ترفض زيارة دمشق، تقول: أخاف أن أقع في حبها ثانية فأتخلى عما أنجزته في سيرتي الذاتية في هولندا، بلاد اللجوء، دمشق معشوقة لا تقبل القسمة!
اليوم يمر السوريون بلحظة وجدانية مكثفة، لذلك من السهولة أن تجد جملة مثل “وعز الشرق أوله دمشق” ترحيباً، واعتزازاً!
وبعيداً عن تلك اللحظة، فإن دمشق بعمقها التاريخي وثقلها الحضاري ورمزيتها السياسية والدينية، رغم الحصار والحرب والانهيارات الاجتماعية التي لا تخفى على متجول في أزقتها رمز لبقاء الدولة السورية.
دمشق ليست مدينة للعيش فحسب بل ساحة وجود، ومرآة وميدان اختبار ومركز انطلاق نحو السلام.
السوريون اليوم معنيون بالإجابة على: كيف ننهض بدمشق؟ وكيف نحول لحظة الاهتمام بها من لحظة انتصار احتفالية إلى تاريخ ديمومة!
السوريون اليوم معنيون بالإجابة على: كيف ننهض بدمشق؟ وكيف نحول لحظة الاهتمام بها من لحظة انتصار احتفالية إلى تاريخ ديمومة!
خيرُ مدخل هو تفعيل الجانب الإنساني في دمشق، دمشق بصفتها حالة أمان، وتراحم وتكافل. دمشق بصفتها حالة تنظيمية، وخدمية، وكذلك كونها مدخل صدق تواصلي.
اليوم يضيع عدد من أبناء دمشق فيها، يشعر كثير منهم بغربة من نوع ما. لعل خير مدخل لتبديد الغربة يكمن بإعادة تفعيل العمل المدني، وبالتـأكيد ليس مطلوباً منها أن تغدو مكاناً للعاطلين عن العمل بل مكان للمقبلين على المبادرات المتميزة والراغبين بالبناء.
دمشق أموية، لكنها قبل ذلك كانت ذات أياد إنسانية، وبعد ذلك يمكن أن تكون، اليوم لديها فرصة لتكون حاضرة بطرائق متخلفة!
تتميز أمستردام بأنها مدينة الحشيش والقنوات المائية والليبرالية، وباريس بأنها عاصمة الموضات والماركات العالمية والفن، ولندن عاصمة التعدد والديمقراطية والبعد الإمبراطوري، والقاهرة ببعدها الفرعوني وحياتها الصاخبة وإسطنبول بالربط بني قارتين ومساحاتها الممتدة وآثارها…فما الذي ستتميز به دمشق مستقبلاً؟ وهي أحد منابع الروح الشرقية!
ليس القرار قراراً سياسياً فحسب، بل قرار مجتمع وتراكم حضارة وسلوكات قاطنين فيها، الفرصة سانحة: لحظة تحول تاريخية، قيادة سياسية تتفهم مكانة دمشق وتعتز بها، شعب لديه رغبة بالسير نحو المستقبل، رغبة إقليمية بتحول الدلالة!
حاول النظام البائد صناعة دلالة مزيفة لدمشق بالصمود والتصدي الكاذب، فيما عقد الصفقات تحت الطاولة وكان من أبشع الأنظمة الاستبدادية!
اليوم، فيما يبدو، السلطة الحالية حريصة عل فتح آفاق الدلالة لنا نحن الشعب المحب للشام، لنسهم في تكريس المعنى، فأي دلالة جديدة نريدها للشام، ينبع من تاريخها الإنساني وينظر للمستقبل؟
الحوار مفيد لنا جميعاً لعلنا نجد دلالات تليق بالشام وتليق بنا نحن محبوها!
الذين نردّد مع الأخطل الصغير: قالوا تحبُّ الشآم؟ قلت جواني مقصوصة فيها وقلت فؤادي!
ومحمود درويش الذي قال: في الشام أعرف من أنا وسط الزحام!
ماذا بقي من الشرق الذي ستكون عزه دمشق؟
بالمفهوم السياسي، دمشق اليوم عاصمة دولة اسمها سوريا، لها حدود معترف بها دولياً، ومطلوب منها أن تستعيد جغرافيتها أولاً، وأن تبسط سيطرتها عليها، وتمدّ يد المواطنة نحوها، لأنه لا شيء يعيد الأطراف إلى المركز مثل دم ينبع من القلب!
أما الرمزية المشرقية لدمشق فستولد ثانية في جانبها الإنساني، لأن دمشق اليوم بالمفهوم العسكري ليست بأحسن أحوالها، وقد يكون ذلك فرصة تاريخية للبحث عن حضور قوة ناعمة غير تقليدي لدمشق.
يقول كثيرون اليوم في سياق لحظة انتصار: دمشق أموية! أياً كان هدف القائلين، من المهم أن نتذكر أنه اليوم ليس عصر الإمبراطوريات والانتصارات والقوة العسكرية. هذه مدخل، الخطوة التالية هي الأهم، خطوات ما بعد الانتصار، لا أحد وحده لديه إجابة نهائية، لا توجد إجابة جاهزة، بل يوجد دلالة سابحة نحن نملؤ معانيها بالدلالات!
من المؤكد أن علينا تثبيت هذا التحول التاريخي لدلالات جديدة لدمشق الشام، وكلنا معنيون بالكتابة والمشاركة!
تلفزيون سوريا
————————
الثورة السورية بوصفها “مؤامرة”.. في تفنيد نظرية جيفري ساكس/ إياد الجعفري
2025.04.20
قبل أسبوع فقط، لم أظن أني سأضطر لكتابة السطور التالية، لتفنيد سردية قدّمها أكاديمي أميركي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مفادها أن الثورة السورية وما تلاها من صراع دامٍ، كانت مجرد نتيجة عَرَضية لبرنامج مخابراتي سرّي أميركي، تم تصميمه تلبية لرغبة إسرائيلية.
إذ يومها، استمعت لبضع دقائق من إجابة البروفسور في جامعة كولومبيا بنيويورك، جيفري ساكس، على سؤال الإعلامي، وضاح خنفر، رئيس منتدى الشرق، حول الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة في سوريا. لم أستطع متابعة الاستماع لكلام ساكس. إذ شعرت أني أستمع لخالد العبود، أو شريف شحادة، أو حتى ناصر قنديل. لذا لم أعبأ بمتابعة بقية المداخلة، وانصرفت عنها. لأُفاجأ بعد يوم، بانتشار واسع النطاق لكلام الرجل، عبر السوشيال ميديا وبعض وسائل الإعلام، مع ترويج لمضمونه، مع عناوين برّاقة من قبيل “14 دقيقة من الحقائق حول سوريا والشرق الأوسط”. وهكذا، وبقدرة قادر، تحولت سردية غير مترابطة متخمة بالمغالطات، إلى “حقائق”!
ووفق تلك السردية، صدر أمر من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بإسقاط نظام بشار الأسد، تلبية لرغبة إسرائيل. وهي رغبة، حسب جيفري ساكس، تعود لأكثر من 25 عاماً. وتستند إلى فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الشرق الأوسط على صورة إسرائيل، وإسقاط كل حكومة تعارضها. وحدّد ساكس موعد صدور أمر أوباما، في ربيع 2011، أي تاريخ اندلاع الثورة ضد النظام. وبناء على هذا القرار، نظّمت وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي إي”، برنامجاً سرياً لتدريب متمردين، خصوصاً من الجهاديين. بما في ذلك الذين تولوا السلطة مؤخراً. حمل البرنامج اسم Timber Sycamore (تيمبر سيكامور). وهو ما أدى إلى حرب طويلة وفوضى تسببت في قتل 600 ألف إنسان، وفق ساكس، الذي نفى أن تكون هذه الخسائر البشرية والمادية الهائلة في سوريا، نتيجة قمع نظام بشار الأسد. وقد خلصت هذه الحرب التي دامت 14 عاماً، إلى النتيجة التي أرادتها الـ “سي آي إي” في 2011، وهو أن تتولى تلك الجماعة الجهادية السلطة في سوريا، بعد أن تم تسليحها من قبل الولايات المتحدة، وفق إدعاءات ساكس. والذي أرجع الحرب في سوريا، إلى استراتيجية تغيير الأنظمة التي تبنتها الولايات المتحدة منذ عهد جورج بوش الابن، بعيد أحداث 11 أيلول 2001. ليخلص إلى أن الولايات المتحدة كانت الفاعل الرئيس في سوريا، طوال تلك السنوات، وحتى اليوم.
يعتبر جيفري ساكس أحد الأكاديميين الأميركيين البارزين في مجال الاقتصاد ودراسات التنمية المستدامة. وقد عمل نحو عقد ونصف كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا التخصص. وهو يحمل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد. لكن خارج حقل الاقتصاد والتنمية المستدامة، لا يمكن الوقوع على معالجات بحثية معمّقة للرجل. خاصةً في حقل سياسات المناطق. وهو ما يظهر جلياً في مواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل، حيال نفي قمع المسلمين الإيغور في الصين، وتأييده الانسحاب الأميركي من سوريا. يُعرف عنه أنه متعاطف مع القضية الفلسطينية، ومن المنددين بالانحياز الأميركي لإسرائيل. لكن طروحاته بخصوص سوريا تؤشر إلى ضحالة كبيرة.
وتستند ادعاءات ساكس في الشأن السوري، إلى جملة ركائز متخمة بالمغالطات، كما أشرنا. أولى تلك الركائز، برنامج Timber Sycamore. وأولى تلك المغالطات، التي تؤكد ضحالة اطلاع ومتابعة الرجل للشأن السوري، هو أن البرنامج المشار إليه، والذي نظمته المخابرات الأميركية بالتنسيق مع مخابرات دول إقليمية (السعودية، قطر، تركيا، الأردن..)، لتدريب المعارضة السورية المعتدلة، في حربها المسلحة ضد نظام الأسد، بدأ في نهاية العام 2012. أي بعد نحو سنة ونصف من اندلاع الثورة في ربيع 2011، وبعد أن انتقل الحراك الثوري إلى مرحلة “العسكرة”، كنتيجة لعنف النظام المفرط. هذه المغالطة وحدها كفيلة بنسف إدعاءات ساكس. لكن في تفاصيل البرنامج المشار إليه، ذاته، هناك مغالطة رئيسة، تنسف ادعاءات ساكس، أيضاً. وهي أن مخاوف مسؤولي إدارة أوباما، من استفادة الجهاديين في سوريا، من برنامج تسليح وتدريب المقاتلين السوريين، كان أحد أسباب انكفاء واشنطن التدريجي عن دعم المعارضة المسلحة ضد الأسد، وتركيزها على محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية – داعش”، وصولاً إلى إقفال البرنامج برمته عام 2017، بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أما ثالث المغالطات الكبرى التي تستند إليها ادعاءات ساكس، فهي رغبة الحكومة الإسرائيلية عام 2011، في إسقاط نظام الأسد. وهي معلومة تخالف عشرات التسريبات والمواد الموثّقة المنقولة عن مسؤولي الحكومات الإسرائيلية المتتالية منذ الـ 2011، والتي تقول عكس ما يدعيه ساكس. كمثال، نحيل إلى تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، عام 2013، ترجمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية، يناقش ما نقلته صحيفة “التايمز” البريطانية، في أيار 2013 عن مصادر استخبارية إسرائيلية، ومفاده أن “بقاء نظام الأسد حتى لو كان ضعيفاً أفضل بالنسبة لإسرائيل وللمنطقة”، وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصادر نفسها “الشيطان الذي نعرفه أفضل من الوضع البديل المحتمل عنه، والذي سيؤدي إلى تدهور سوريا إلى حالة من الفوضى، وتحولها إلى موطئ قدم للمتطرفين من العالم العربي”. ويشير التقرير إلى أن تعبير “الشيطان الذي نعرفه” سبق واستخدمه رئيس الحكومة أرييل شارون عام 2005، عندما شرح للرئيس الأميركي جورج دبليو بوش سبب معارضته الإطاحة بنظام الأسد، وذلك خشية وصول الإسلاميين إلى السلطة في دمشق. وهو ما ينسف نظرية ساكس عن رغبة إسرائيل القديمة بإسقاط نظام الأسد التي تعود لـ 25 سنة قبل الـ 2011. تقرير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أشار إلى المفاوضات الجدّية التي أجراها نظام الأسد مع حكومة بنيامين نتنياهو بين عامي 2010 و2011، بوساطة تركية. وهي المفاوضات التي وصلت إلى مراحل متقدمة، لولا اندلاع أحداث الثورة في آذار 2011، والتي دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف المحادثات، واتخاذ وضع المترقب، لمتابعة التطورات في المشهد السوري.
ومن الغريب، أن ساكس، في أثناء عرضه لسرديته غير المترابطة، لم يشرح لنا، لماذا أرادت واشنطن وتل أبيب إيصال الجهاديين إلى السلطة في دمشق! أيُعقل أن تل أبيب راهنت على أن هؤلاء الجهاديين سيوفرون بيئة أكثر أمناً من تلك التي وفّرها نظام الأسد منذ العام 1973، قرب هضبة الجولان المحتلة! الجواب جلّي في الاستنفار العسكري الإسرائيلي غير المسبوق منذ سقوط نظام الأسد، بغية تدمير كل ما يمكن أن يشكّل ركيزة قوة عسكرية للسلطة الجديدة في دمشق.
اللافت في سردية ساكس، حذفه للشعب الثائر في سوريا، كليةً، من المعادلة التي حكمت المشهد خلال السنوات الفائتة. ونفيه المطلق لأثر جرائم النظام البائد في تفاقم الكارثة وتعقيدها. وإصراره على إرجاع كل ما حدث للإرادة الأميركية – الإسرائيلية. تلك الإرادة التي تغيّر كل ما تريد، وقتما تريد، وكيفما تريد، في منطقتنا. أتكون هذه الرسالة، هي “المؤامرة” المقصود الإيحاء بها لعقول أبناء منطقتنا، بعد أشهر من انتصار الثورة؟ نترك هذا السؤال برسم من قدّم لهذا الرجل، ومن روّج لسرديته التي تبخس من قدرات السوريين وبقية شعوب المنطقة، على التغيير.
تلفزيون سوريا
———————–
صناعة المناهج التعليمية للأطفال في سوريا الجديدة/ ميساء حسين
2025.04.20
تلعب المناهج التعليمية دوراً محورياً في تشكيل شخصية الطفل وتوجيه سلوكه، كما تسهم في بناء معارفه ومهاراته وقيمه منذ السنوات الأولى من عمره. وفي سوريا، التي خرجت من حرب قاسية امتدت لسنوات طويلة، تزداد أهمية إعادة التفكير في كيفية صناعة المناهج التعليمية للأطفال، خاصة بعد أن تسببت الحرب في تدمير نحو 60 بالمئة من المدارس وانقطاع عدد كبير من الأطفال عن التعليم، فضلاً عن تراكم آثار نفسية واجتماعية عميقة.
ومن التحديات التاريخية التي واجهها التعليم السوري، أن المناهج كانت تُستخدم لأغراض حزبية ضيقة وتكريس مفاهيم دكتاتورية، الأمر الذي يدفعنا اليوم لصياغة منهج جديد يؤمن بالحرية والتعددية ويركز على بناء إنسان حر وفاعل.
أولاً: ما هو المنهج التعليمي؟
المنهج التعليمي لم يعد مجرد كتاب مدرسي أو مجموعة من الدروس المقررة، بل هو منظومة متكاملة تشمل كل ما يتعلمه الطفل داخل المدرسة وخارجها. يشمل ذلك المحتوى الدراسي، أساليب التدريس، الأنشطة المرافقة، والتقويم، وحتى القيم والاتجاهات التي يُراد غرسها. وفقاً للمنظور الحديث، يُنظر إلى المنهج على أنه عملية ديناميكية تهدف إلى تطوير الطفل في جميع جوانب شخصيته.
ثانياً: المصادر التي تُبنى عليها صناعة المنهج
تعتمد صناعة المنهج التعليمي على عدة مصادر رئيسية، يمكن تلخيصها فيما يلي:
خصائص النمو لدى الأطفال
يأخذ المنهج الجيد بعين الاعتبار المراحل العمرية المختلفة وخصائص كل مرحلة، سواء كانت جسدية أو معرفية أو اجتماعية أو نفسية. فالطفل في سن الثالثة لا يتعلم بنفس طريقة طفل في العاشرة، ولهذا يجب أن تكون المناهج مرنة ومناسبة لنمو الطفل.
الثقافة والبيئة الاجتماعية
في السياق السوري، ينبغي أن يعكس المنهج التعدّد الثقافي والديني، ويعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة الجامعة. كما يجب أن يكون حساساً للواقع الاجتماعي والنفسي للأطفال الذين عاشوا في بيئات الحرب والنزوح والحرمان.
الأهداف التربوية
تشكل الأهداف القاعدة التي يُبنى عليها المنهج، وهي تحدد الغاية النهائية منه. في الحالة السورية، ينبغي أن تهدف هذه المناهج إلى إعادة بناء الثقة بالمدرسة، دعم التماسك الاجتماعي، وتمكين الأطفال من التعبير عن أنفسهم بحرية وتنمية تفكيرهم النقدي.
المعارف والعلوم الحديثة
تتغير المعارف باستمرار، ولهذا يجب أن يكون المنهج مواكباً لأحدث ما توصلت إليه العلوم المختلفة، مع التركيز على بناء المهارات الحياتية والتقنية التي تُعدّ الأطفال للاندماج في عالم معقد ومتشابك.
التجارب والخبرات السابقة
تُستفاد من النماذج الناجحة محلياً وعالمياً في صناعة المناهج، كمنهج منتسوري، ريجيو إيميليا، والدورف، وغيرها. ويجب مراجعة التجربة السورية السابقة بوعي نقدي، للتخلّص من التلقين الإيديولوجي وتعزيز التفكير المستقل.
الوسائل والتكنولوجيا
نظراً للدمار الذي طال البنية التحتية في سوريا، يمكن أن تساهم الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية في تعويض النقص، إذا ما تم استخدامها بذكاء لتوفير التعليم عن بُعد وتقديم محتوى تفاعلي وجاذب.
ثالثاً: خطوات تصميم المنهج
عملية تصميم المنهج ليست عشوائية، بل تمر بعدة مراحل مترابطة
تحليل خصائص الفئة المستهدفة: فهم قدرات الأطفال، خلفياتهم الاجتماعية والثقافية، وظروفهم النفسية بعد الحرب.
تحديد الأهداف: وضع أهداف عامة وأخرى خاصة تتوافق مع احتياجات إعادة الإعمار الاجتماعي والنفسي، وتعزز قيم التعايش والمواطنة وحقوق الإنسان.
اختيار المحتوى: ينبغي أن يكون المحتوى مناسباً للعمر، متدرجاً، ومتصلاً بالحياة الواقعية، ويُعيد ربط الطفل ببيئته وهويته دون حشو أو شعارات فارغة.
تنظيم المحتوى: يُنظم المحتوى بشكل هرمي من البسيط إلى المعقد، ومن المعلوم إلى المجهول، مع مراعاة التكامل بين المواد المختلفة وتجاوز الفصل الجامد بينها.
اختيار طرق التدريس: يُفضل استخدام الأساليب النشطة والتفاعلية، مثل التعلم من خلال اللعب، المشاريع، التعلم التعاوني، والحكاية، وهي أدوات فعّالة في معالجة صدمات ما بعد الحرب.
التقويم: لا يقتصر على الاختبارات، بل يشمل ملاحظات المعلم، ملفات الإنجاز، التقييم الذاتي، والتقييم التكويني المستمر، مع التركيز على تقدم الطفل لا على مقارنته بغيره.
رابعاً: مناهج تعليمية رائدة على مستوى العالم
من المفيد الاطلاع على بعض النماذج العالمية التي أثبتت فعاليتها في تعليم الأطفال:
منهج منتسوري: يركز على استقلالية الطفل، ويمنحه حرية اختيار الأنشطة في بيئة معدّة جيداً ومحفّزة.
منهج والدورف: يعتمد على الدمج بين العقل، اليد، والقلب، ويركز على الفنون والخيال واللعب الإبداعي.
ريجيو إيميليا: منهج يقوم على احترام قدرات الطفل ويشجعه على التعبير الحر، ويؤمن بأن كل طفل له مئة لغة للتعبير.
خامساً: التحديات الراهنة في صناعة المناهج
في سوريا رغم التطور في الفكر التربوي، لا تزال صناعة المناهج في سوريا تواجه تحديات عدّة، منها:
الإرث السياسي للمناهج: التحرر من المناهج السابقة التي كرّست فكراً أحادياً وديكتاتورياً مهمة أساسية لإعادة بناء تعليم حر ومنفتح.
ضعف البنية التحتية: تدمير عدد كبير من المدارس ونقص الكوادر المؤهلة يعقّد مهمة تطبيق أي منهج جديد.
المركزية الزائدة: تصميم المناهج من جهات مركزية دون إشراك المعلمين أو الميدان التربوي يفقدها المرونة والواقعية.
غياب الدعم النفسي: لا بد من دمج الدعم النفسي ضمن المنهج، لا كمادة منفصلة بل كأسلوب تفكير وأسلوب تدريس يعيد التوازن للأطفال المتضررين.
إن صناعة المنهج التعليمي للأطفال في سوريا ما بعد الحرب ليست مجرد عملية تقنية، بل هي مشروع وطني وإنساني يتطلب رؤية تربوية جديدة تنطلق من واقع الطفل السوري واحتياجاته الحقيقية. المناهج اليوم يجب أن تكون أكثر من مجرد أدوات تعليمية، بل جسراً نحو التعافي، والمصالحة، وبناء مستقبل قائم على الحرية، الإبداع، والانتماء. إن نجاح هذا المشروع مرهون بإرادة حقيقية لتجاوز الماضي والانفتاح على المستقبل، وإشراك كل الفاعلين التربويين في هذه المهمة النبيلة.
تلفزيون سوريا
————————————–
المقاتلون الأجانب واحتكار السلاح في سورية/ عمار ديوب
20 ابريل 2025
يقتضي الانتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة سياسات وطنية عامّة تقطع مع المرحلة السابقة. يتطلّب النهوض بالدولة إشراك فئات الشعب كافّة وإرضاءها، بغض النظر عن تنويعاتها السياسية والقومية والدينية. وجود مقاتلين أجانب، وفي حالة كارثية في سورية، إلى جانب التنوّع، يستدعي إبعادهم بشكل كامل من شؤون الدولة كلّها، وتحديداً من الجيش والاستخبارات والمناصب السيادية، كما أن حدّة الاستقطاب الطائفي والقومي والضغط الخارجي والحدود مع الدولة الصهيونية يستدعي هذا الإبعاد.
تخلّصت سورية مع زوال نظام الأسد من المقاتلين الأجانب الداعمين له، وهناك ضغط أميركي وتركي، وسوري داخلي، للخلاص من الأجانب الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبالكاد تكتب التقارير الصحافية عن أجانب لدى بقايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتواجه السلطة الحاكمة في سورية نقداً شديداً لوجود المقاتلين الأجانب، ولا سيّما أنّها وضعت بعضهم في مناصب عُليا بالجيش، وأثار الأمر حفيظة السوريين، خاصّة الضبّاط المنشقّين من جيش النظام السابق، فهم من ضحّى بكلّ شيء، والتحق بالثورة، ولا يزالون مُستبعدين من المشاركة في إعادة تأسيس الجيش. كان للمقاتلين الأجانب دور كبير في تصفية فصائل الجيش الحرّ منذ 2012، سواء بتحالفهم مع جبهة النصرة أو “فتح الشام” أو هيئة تحرير الشام أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو “قسد”، وبالطبع، مارس الأجانب ضمن المليشيات الإيرانية أكبر الأدوار في دعم السلطة، وإفشال الثورة. إذاً هناك عدد كبير من المقاتلين الأجانب وفدوا إلى سورية وقاتلوا في مواقع متعدّدة، ويكمن دورهم في تغييب أهداف الثورة وحرف الصراع ليصبح صراعاً طائفياً.
الآن، هناك طلبات داخلية وخارجية للخلاص من الأجانب في ميدان الجيش والدولة، وهي مطالب محقّة، وهي من شروط رفع العقوبات الأميركية والدولية عن سورية، وهناك مطالب كثيرة تتعلّق بإشراك القوى السياسية والاقتصادية والثقافية من خارج مجموعة هيئة تحرير الشام، ومن يدور في فلكها. ورفض إبعاد الأجانب بحجّة قتالهم النظام، وأن هيئة تحرير الشام بذلك تخون المتحالفين معها، وأن هناك مقاتلين أجانب كثيرين اعتُرف بهم في دول كثيرة (كما يقول إعلاميو السلطة)، فيه كثير من عدم فهم واقع سورية الكارثي، والممتدّ بحالة الدمار والإفقار منذ 2011، بل وما قبل 2011، وكذلك فيه تجاهل لدور الأجانب داعمي “الهيئة”، فلقد كانوا ضدّ النظام والفصائل الحرّة معاً، فيُنظَر إليهم أعداءً للثورة السورية، وخطراً كبيراً على إعادة تأسيس الجيش بشكل وطني، وهناك عقائدهم البعيدة من الوطنية السورية، وكان مجيئهم إلى سورية بقصد محاربة “النصيرية” وبناء “دولة الخلافة”، وهناك رفض كامل منهم لأيّ مفرداتٍ تتعلّق بالديمقراطية أو المواطنة أو التعدّدين الديني والقومي. تتعارض رؤى عقائدية كهذه بشكل حاسم مع بناء دولة للسوريين كافّة، والسوريون العلويون جزء منهم بالضرورة. إذاً هناك أسباب كثيرة، وليس طلبات الخارج فقط، تستدعي إبعاد المقاتلين الأجانب.
حاججت كلّ من “قسد” ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بعض الوقت بأن وجود الأجانب في الجيش المُراد تشكيله يُضعف مطالبة السلطة بإبعاد الأجانب الداعمين لـ”قسد”، ولكن الأمر يخصّ أيضاً فصائل السويداء، وحتى الفصائل الداعمة للسلطة ذاتها، فالأغلبية السورية لا تريد مقاتلين أجانبَ في أراضيها. التشكيك بتوجّهات السلطة، وعدم استجابتها لإبعاد هؤلاء الأجانب، ولا سيّما بعد دورهم في مجازر الساحل الطائفية بامتياز، في أوائل الشهر الماضي (مارس/ آذار)، ينتقص من حقّها في احتكار السلاح، إذ ليس من المعقول الموافقة على تسليم السلاح والانتظام في جيشٍ يتشكّل وفيه قيادات أجنبية، أو يتحالف مع جماعات جهادية من أوزبك وشيشان وتركمانستان ومغاربة وسواهم.
أصبحت مسألة إبعاد الأجانب حاسمةً، وتضغط أميركا وأوروبا لإبعادهم بشكل كبير، وهناك تجميد جديد لرفع العقوبات من الاتحاد الأوربي بسبب عدم استجابة سلطة دمشق للشروط الأوروبية، ومنها استبعاد الأجانب، وهناك تقييم سلبي أميركي كبير للسلطة، والاتجاه نحو عدم الاعتراف بها، وبالتالي، هناك أسباب كثيرة تدفع نحو تغيير السلطة توجّهاتها وفكّ العلاقة مع الأجانب العقائديين، وتحويلهم إلى العمل الاقتصادي، وفي حال رفضهم ذلك، فإبعادهم إلى الخارج. وفي الإطار ذاته، لا يجوز السماح لهم بالمشاركة في العمل الدعوي، فالدعويُّ في حالة الأجانب، السلفيين الجهاديين، سيكون متعارضاً مع الوطني، ومع تعزيز الاتجاهات الإسلامية الوطنية.
تتجه السلطة في دمشق إلى تشريع نفسها عبر العلاقة مع الخارج، وإذ بدأت بالشعور بثقل المطالب الأميركية والأوروبية راحت تتجه نحو تركيا والخليج للمساهمة في التخفيف من ذلك الثقل، وجولة الرئيس أحمد الشرع الإقليمية، أخيراً، تأتي في هذا الاتجاه، وبهدف تأمين الدعم وتشريع سلطته، وإن نال بعض الدعمين المادي والسياسي، فإن الشروط الدولية ستظلُّ الأساس في العلاقة مع دمشق. تتعزّز قوّة السلطة تجاه الشروط الدولية عبر الحقوق التي يتمتع بها الشعب، فهل ستعي السلطة أن الشعب هو مصدر الشرعية والقوّة؟
تعيد السلطة الحالية سياسات النظام القديم، الذي أدار ظهره للشعب وتحالف مع إيران ومليشياتها وروسيا، وكانت الحصيلة انهيار حكمه، الذي أُجِّل منذ 2012 إلى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024. وسورية لا تحتمل تكرار السياسات نفسها، وهي في حالة كارثية، وفي المستويات كافّة، وتتطلّب سياسات وطنية في الاقتصاد والتعليم والثقافة والجيش وإدارة مؤسّسات الدولة، وإشراك الفعّاليات السياسية والثقافية وسواها، المستقلة عن السلطة. هنا مصدر الشرعية، ومن هنا الرفض الواسع لتنصيب المقاتلين الأجانب بقيادة الجيش أو جعلهم فصيلاً فيه. ينتهك هذا وطنية السوريين، ويؤسّس جيشاً غير وطني.
تخطئ السلطة في محاولة تشريع نفسها عبر الخارج، فللخارج مصالحه، وهناك أشكال من التعارض بين مصالح الخارج ومصالح الداخل، ويتقلّص التعارض بمقدار الانطلاق من مصالح الداخل، إذ ستكون مصالح الداخل الأساس في أيّ مفاوضات بخصوص النهوض بسورية، وفي غياب الشرعية الداخلية ومصادر القوة الداخلية، ستتعرّض السلطة لضغوط كبيرة، وستنتقل لاحقاً لتصبح أداةً بيد الخارج، وربّما تنهار سريعاً.
قوة السلطة الحالية متأتية من إسقاط النظام التابع وتخليص سورية من النفوذين الإيراني والروسي، ومن شعور الشعب بأن ثورته انتصرت أخيراً. سيتغيّر هذا التفكير كلّه باستمرار إدارة الظهر للشعب. ومسألة المقاتلين الأجانب قضية حساسة في سورية، وستكون قابلة للانفجار في أيّ لحظة، سواء بسبب رؤية هؤلاء الأجانب السلفية المتعارضة مع التديّن السوري السائد، أو رغبتهم في تقييد توجّهات السلطة “الوطنية” الجديدة، أو من خلال الضغوط الخارجية والاستمرار في العقوبات، وهناك الدولة الصهيونية التي تنتقد سلطة دمشق، وتقدّمت باتجاه ثلاث محافظات، بسبب “مخاطر السلفية الجهادية”، كما تدّعي.
سيكون الإصرار على عدم إبعاد المقاتلين الأجانب سبباً في تراجع الدعم الإقليمي والدولي، والمصدر الأساس لشرعية السلطة هو الاستجابة لمصالح الشعب وحقوقه والمسارعة بإبعادهم، ومن دون ذلك ستظلُّ الشرعية منقوصة، وهناك إمكانية لأشكال التدخّل الخارجي، وعكس ذلك حينما تتبنّى السلطة مشروعاً وطنياً وديموقراطياً ويتمظهر في شؤون الدولة كلّها.
العربي الجديد
—————————————————–
الثقافة السورية في العهد الجديد/ بشير البكر
الإثنين 2025/04/21
لا يبدو أن مستقبل الثقافة السورية سيكون بخير مع الوزير الجديد محمد صالح، الذي قدم نفسه في حفلة تنصيب الحكومة السورية، وأقسم اليمين الدستورية بأبيات من الشعر ذات رؤية سياسية على قدر من الخفة، وتفتقر إلى العمق والرصانة التي يجب أن يتحلى بها المسؤول، عندما تضعه الأحداث أمام مهمة تنوير الناس في الأزمنة الصعبة والاستثنائية، ومنهم أهل بلدنا سوريا، التي عانت في العقود الأخيرة من محاولات تجفيف منابع الثقافة، وتحويل البلد إلى صحراء في عمل ممنهج لتجهيل السوريين، وفرض حالة من الأمية الثقافية على مجتمع، ظلت الثقافة، عبر تاريخه الطويل، أحد أسلحة دفاعه عن هويته الوطنية.
سوريا بلد ثقافي بامتياز، ولها دور رائد في اغناء الثقافة العربية وتجديدها، منها ظهر شعراء كبار مثل نزار قباني، وعمر أبو ريشة، وبدوي الجبل، ومحمد الماغوط، وروائيون متميزون مثل حنا مينه، وقصاصون مجددون كزكريا تامر، ومفكرون تنويرون كصادق جلال العظم، ورسامون مثل لؤي كيالي وفاتح المدرس ونذير نبعة، وكتاب مسرح كسعد الله ونوس، وسينمائيون كمصطفى العقاد.
مضى قرابة ثلاثة أسابيع على تسلم وزير الثقافة الجديد مهامه، وكان من المنتظر منه أن يقدم تصوره لما يمكن أن تقوم به الوزارة من عمل عاجل لإسعاف المؤسسات الثقافية العاطلة عن العمل، أو على الأقل زيارة المسارح المغلقة مثل الحمرا والقباني والخيام، التي شهدت نهضة سوريا المسرحية، وصالات السينما كالكندي، التي تشكل فيها الوعي والثقافة السينمائيين لأجيال سورية في السبعينيات والثمانيات، أو المراكز الثقافية، أو أن يلتقي بما بقي داخل سوريا من مثقفين، صمدوا خلال الحقبة الأسدية السوداء ودفعوا ثمنا كبيرا للدفاع عن ثقافة وهوية السوريين.
اقتصرت نشاطات الوزير على زيارة لضريح الشيخ الشيعي محسن الأمين ومقام السيدة زينب، في 17 نيسان يوم استقلال سوريا، وأخرى جرى نشر صورها على وسائل التواصل لشيخ عشائري من البوكمال بريف دير الزور، يدعى فرحان المرسومي، وذلك برفقة جمال الشرع شقيق رئيس الدولة، وهذا من حقه، ولكن وسائل التواصل حفلت بأخبار وصور عن هذا الشيخ، الذي تحدث ناشطون أنه كان مهرب “كبتاغون”، وأحد أذرع الحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال، والفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد. وإن ذل ذلك على شيء فهو يعبر عن عدم مراعاة مشاعر الناس، قبل خدش مكانة الموقع الذي يتولاه كممثل للدولة وللشأن العام أولا، وكوزير للثقافة ثانيا، التي تتطلب من الرجل التي يقودها أن يتوافر على قدر عال مما يتحلى به المثقف من نزاهة واحترام للناس.
لا ينتظر السوريون ثقافة مَضافات، وعباءات عشائرية، واستعراضات في وسائل التواصل، بل ثقافة اختلاف وتجديد. أي وزير يتسلم هذا المنصب، يجب ألا يكون أقصر قامة من الوزيرة نجاح العطار صاحبة الدور المشهود له في نهضة سوريا ثقافيا في الثمانينات. ولذا يجب أن تسند المهمة في العهد الجديد إلى شخص يمتلك ثقافة حقيقية، ورؤية تليق بسوريا الجديدة.
تحتاج سوريا اليوم إلى ثقافة تقطع مع العهد البائد، ليس على أساس الترويج لمقولات وخرافات شعبوية، تتوسل كسب متابعين على وسائل التواصل، بل على أساس مفاهيمي فعلي يضع الثقافة في مكانها الصحيح في المجتمع، من كونها أحد مصادر المناعة والإعلاء من قيمة الوعي في حياة الناس، الذين تعرضوا على مدى عقود إلى عمليات اضطهاد ثقافي، لا يقل قسوة عما حصل سياسيا، حيث تم اغراق البلد بالدراما الرديئة، والمسلسلات الهابطة، والكتب السطحية، وتحولت المؤسسات الثقافية إلى مراتع للأمن، ورديف للمؤسسات القمعية، وهذا واضح في حال اتحاد الكتاب، الذي اداره بعض موالون للنظام السابق، ومنهم نضال الصالح، الذي تم طرده من التدريس الجامعي، بسبب تزوير شهادته العلمية، واستقال من رئاسة الاتحاد عام 2019، نتيجة حملة قادها ضده أعضاء من الاتحاد اتهموه بالتعامل بعقلية الشبيح، الذي استبعد أي كاتب لا يتفق معه شخصياً بزعم أنه متآمر ومناهض للنظام، حتى لو كان مؤيداً.
هناك ظواهر غير مبشرة مثل تعيين لجان لتسيير بعض المؤسسات، نقابة الفنانين، نقابة التشكيليين، واتحاد الكتاب، وقد صدر ذلك عن جهة رسمية تابعة لوزارة الخارجية تدعى أمانة الشؤون السياسية، التي بات من المتعارف أنها هيكل سياسي جديد، تعتمده السلطة كجهاز للحكم. ويرى معارضو ذلك أن الانتقال إلى وضع جديد، لا يتم من خلال تكريس أساليب عمل السلطة السابقة، أو استنساخ طرق عملها، أو تقليدها، ويجب ألا يقتصر الأمر على الهياكل، بل الأفراد أيضا. ومن المنتظر أن يكون الأشخاص في المواقع الأمامية معبرون عن الروحية الجديدة للبلد المدمر، والذي لا يملك سوى الرصيد الأخلاقي الكبير، الذي كونه بفضل صموده وتضحياته وصبره وتشرد أبنائه في معركة الخلاص من الطغيان. وعلى هذا ليس من الحصافة بمكان الاستهانة بالسوريين أو الاستخفاف بوعيهم، أو التأثير عليهم بأساليب وشعارات تجرهم الى الوراء، واستغلال الهشاشة الاقتصادية وحال التعب الذي يعيشونه.
تنهمك فئات واسعة من المثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال والفنانين والمؤثرين على وسائل التواصل، بالدفاع عن التحول السوري الذي حصل في الثامن من كانون الأول، لكن العديد من الذين يتولون مناصب رسمية في السلطة الجديدة، ليسوا على قدر من الوعي بالتحديات التي تواجه البلد، على طريق استكمال وحدته الداخلية، وبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة.
المدن
———————————-
إن كان البيت الفرنسي من زجاج…/ سلام الكواكبي
الإثنين 2025/04/21
يعبر البحث العلمي في العلوم الإنسانية أسوأ أيامه، في الدول الأوروبية عموماً وفي فرنسا خصوصاً. منذ سنوات قليلة، ومع تطرف التوجهات النيو ليبرالية، اتجهت الخيارات الرسمية كما الاقتصادية والمالية إلى تعزيز الرهان وحصره بالحقل العلمي التطبيقي. وابتعدت المؤسسات العامة العاملة في تمويل المشاريع الإنمائية عن الانخراط في دعم الأبحاث المتعلقة بالعلوم الإنسانية. فصار من الطبيعي، بل من الواجب، أن تتوجه المخابر العلمية ومخابر التفكير والوحدات البحثية المختلفة للتركيز على محاولة الحصول على تمويل برامجها من أصحاب الثروات الكبيرة، ضمن مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
إن ظاهرة تراجع التمويل الحكومي للبحث العلمي في أوروبا، وخصوصًا في فرنسا، أصبحت قضية بارزة تُثير الكثير من النقاشات بين الأكاديميين والباحثين وصنّاع السياسات. ففي في السنوات الأخيرة، وفي ظل تقليص الإنفاق العام بسبب التراجع الاقتصادي الحاد في الدول الغربية والضغوط المالية وتفاقم الدين العام، تراجعت بحدة الميزانيات المخصصة للبحث العلمي.
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية المتكررة حول ضرورة الاهتمام بـ”اقتصاد المعرفة” والعمل على تشجيع “الابتكار”، فإن الواقع يشير إلى تباين كبير بين القول والفعل. وفي ظلّ وجود تمويل أوروبي يغطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للأبحاث العلمية، إلا أنه لا يمكن أن يحل مكان الدعم والتمويل الوطني. وما زالت بعض الدول في شمال أوروبا تستثمر بكثافة، لكن دولًا أخرى تعاني من تقلبات واضحة. تودي في أغلب الأحيان إلى تراجعات حادة في تمويل ودعم البحث العلمي.
أيضاً، وعلى الرغم من أن البحث العلمي يُعدّ في فرنسا كجزء محوري من الهوية الوطنية، لكن تبين، خصوصاً في العقد الأخير، ظهور تراجعات حادة في هذا الحيّز. وقد ظهر هذا تراجع بقوة في مجال التمويل العام للبحوث العلمية. وعلى الرغم من تعهد الدولة الفرنسية برفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير العلميين إلى ما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما تنص عليه توصيات وأهداف الاتحاد الأوروبي، إلا أن الرقم الحقيقي لا يتجاوز 2.2%. ومع تراجع الدعم الحكومي، فإن نسبة كبيرة من هذا التمويل تتأتى من القطاع الخاص. وسجل الإنفاق الحكومي مقابل الخاص تراجعاً نسبياً واضحاً. وبعيداً عن مراكز البحث العلمي، فإن الجامعات تعاني من نقص حاد في ميزانيتها. ومن المطلوب منها أن تسعى لتحصيل مصادر تمويل من خارج الإطار الحكومي وبجهود ذاتية. ويؤدي ذلك إلى نقصان حاد في الميزانيات التشغيلية، وبالتالي تتقادم المعدات وتضعف فرص تمويل المشاريع الجديدة. يضاف إلى ذلك كله زيادة البيروقراطية المعمول بها. ومن أهم من نتائج هذا الخلل في مسار الدعم والتمويل بروز ظاهرة مغادرة الباحثين والباحثات إلى دول تتوفر فيها بيئة بحثية أكثر ترحيباً. وكذلك تتوفر على تمويل أكثر استقراراً. وكانت كندا تشكل حيز استقطاب مميز لما يمكن أن نسميه بهجرة العقول الفرنسية.
ومن المؤكد أن الأمر يختلف بين تمويل البحث العلمي في العلوم الإنسانية وبين تمويل البحث العلمي في العلوم التطبيقية. فمع التوجه نحو المال الخاص، والذي تشجع الدولة على تبنيه، فسيكون للعلوم التطبيقية والتجارب التطبيقية حصة الأسد منه. فمن النادر أن يشجع الرأسمال على القيام بدراسة اجتماعية معمقة تركز على فهم الإنسان والثقافة والسلوك المجتمعي، أو بتحليل السياسات الإقليمية أو بالوقوف أمامه التحديات الدولية. إن العلوم الإنسانية التي تعتمد غالباً على التحليل النوعي والتأمل النقدي والمقاربات النظرية، لا تحتاج إلى مختبرات أو أجهزة مكلفة، كما أن نتائجها غير قابلة للقياس الكمي بدقة. إن مخابر الفيزياء والكيمياء كما الرياضيات، أي القطاعات ذات القيمة العالية، والتي تؤدي نتائج أبحاثها غالباً إلى مردود ملموس، من تطوير أو من اختراعات، فهي ستحظى باهتمام ودعم وتشجيع المال الخاص. وبالنتيجة فإن الجامعات والمراكز البحثية الفرنسية تتراجع في التصنيفات العالمية. كما تؤدي هذه الظاهرة إلى إضعاف الابتكار الوطني في كافة المجالات. ويزداد الشعور لدى الأكاديميين بأن البحث العلمي لا يعد أولوية وطنية البتة. كما تترسخ ظاهرة تآكل الثقة بين العاملين في البحث العلمي وخصوصاً في العلوم الإنسانية من جهة، وبين الحكومة والقائمين على السياسات العامة من جهة أخرى.
صناع القرار يرون أن العلوم الإنسانية والاستثمار فيها هو جهد غير منتج اقتصاديا بالمقارنة بالعلوم التطبيقية. وعلى الرغم من أن تكاليف مشاريعها البحثية أقل من تكاليف المشاريع البحثية في العلوم التطبيقية لكنها تلقى صعوبة أكبر في إثبات عوائدها الاقتصادية المباشرة. وبالتالي، فإن تراجع التمويل الحكومي يؤثر على حقل الأبحاث في العلوم الإنسانية بقوة، لأن تمويلها أصغر أصلاً، وهو يعتمد غالبا على الحكومة.
منذ عدة أيام، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فتح باب اللجوء العلمي للباحثين والباحثات من الولايات المتحدة الأميركية، والذين يعانون من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعادية للجامعات وللبحث العلمي. معتبرًا بأن فرنسا مستعدة لاستقبالهم وتأمين فرص عمل لهم واستمرارهم في أبحاثهم العلمية في المجالات كافة. معتبراً بذلك بأن البحث العلمي يتعرض لإفقار اقتصادي ولقمع سياسي في المشهد الأميركي. ويبدو أنه قد غاب عن الرئيس الفرنسي تعرض حقل البحث العلمي الفرنسي نفسه لإفقار اقتصادي إن لم يكن تطبيقياً وذا نتائج مباشرة يمكن تقييمها بالأرقام. كما يتعرض البحث العلمي في العلوم الإنسانية إلى تضييقات سياسية تصل إلى حد إعادة إنتاج المكارثية التي عرفتها أميركا في خمسينات القرن الماضي.
وفي حين يدعو ماكرون إلى استقبال “اللاجئين” الأميركيين في حقل البحث العلمي الفرنسي، يشهد هذا الأخير تراجعاً بنيوياً كبيراً، في الجانب المالي والتمويلي، وكذلك في هامش الحريات الأكاديمية الذي يضيق أكثر فأكثر، وخصوصا في العلوم الإنسانية. وسيكون المجتمع العلمي الفرنسي على موعد بعد يومين مع محاكمة الأستاذ الجامعي المعروف فرانسوا بورغا، المتخصص في العلوم السياسية للمجتمعات الاسلامية، وذلك بتهمة التحريض على العنف والإرهاب لمجرد تعبيره عن رأيه فيما يحصل من مقتلة وإبادة جماعية في عزة.
من الأجدر على الرئيس ماكرون وقبل دعوته للباحثين الأميركيين إلى اللجوء إلى بلده أن يدافع عن حريات باحثي بلده.
المدن
————————————-
ليس في سورية أكثريّة سياسيّة حاسمة/ فاروق مردم بيه
الإثنين 2025/04/21
ليس في سورية أكثريّة سياسيّة حاسمة لا لحُكّامها الحاليّين – ولا لغيرهم.
لدينا أقلّيّاتٌ إثنيّة وطائفيّة (لنقل من 30 إلى 35% من السكّان) تتوجّس من هؤلاء الحكّام منذ تسلّمهم السلطة، وقد تأكّدت مخاوفها بعد مجزرة الساحل واستهتار السلطة بآثارها المريعة على النسيج الوطني وإفلات المجرمين من العقاب.
وخلافاً للتصوّرات السائدة، لا يُمثّل أحمد الشرع وصحبه الأكثريّة الإثنيّة الطائفيّة (أي العرب المسلمين السنّة)، بل هامشاً منها بضيق أو يتّسع بحسب أفعالهم لا أقوالهم، ولا يُمكن أصلاً في أيّ ظرفٍ كان أن يُمثّلها أحدٌ برمّتها بسبب تنوّعها الجغرافيّ والاجتماعي والثقافي ومزاجها السياسيّ الميّال إلى التعدّديّة.
وواقع الحال أنّ هيئة تحرير الشام، بسبب تناقضاتها الداخليّة أو هوسها بالسلطة المطلقة أو حذرها من بعض الفصائل الجهاديّة المتحالفة معها، لم تنفتح على هذه الأكثريّة ولم تسعَ إلى استقطاب نُخبها المدينيّة على الرغم من حاجتها الماسّة إليها ومن موقف هذه النخب الإيجابي أو المُحايد على الأقلّ، وشرعت في بناء دولتها مُعتمدةً على “حواضر البيت”، ومُصرّة إصراراً عجيباً على ارتكاب الخطأ بعد الخطأ.
وأغلب الظنّ أنّ الدولة الناشئة ستعمل تدريجيّاً، للتعويض عن فشلها الأمني والمعيشي، على فرض وصايتها الدينيّة – الأخلاقيّة، ثمّ السياسيّة، على المجتمع السوري، خصوصاً على أكثريّته العربيّة السنّيّة، مُحاولةً الاستفادة من العطالة السياسيّة التي يُعاني منها منذ عشرات السنين، ولكنّها لن تنجح إلّا باستعداء فئاتٍ اجتماعيّة لم تُناصبها العداء من قبل.
وفي حساب الموالاة والمُعارضة، على “الديموقراطيّين العلمانيّين”، أو من يصفون أنفسهم بهاتين الصفتين، أن يعوا بأنّهم “الأقلّيّةٌ” الأضعف على الصعيد الوطنيّ العام وضمن كلّ إثنيّة وطائفة، ولن يتغيّر الأمر ما داموا قانعين بتعاويذهم “الليبيراليّة” المُملّة، يستعيضون بها عن النضال السياسيّ المُنظّم.
وأمّا اليسار (وكم نحن بحاجةٍ إلى يسار!)، فقد أصبح فزّاعةً رثّة تتندّر بها العصافير…
(*) مدونة نشرها الباحث السوري فاروق مردم بيه في صفحته الفايسبوكية
—————————-
محمود عباس ضيفاً في سوريا الجديدة… نعم ولكن/ ماجد عزام
الإثنين 2025/04/21
مبدئياً يجب الترحيب بزيارة الرئيس محمود عباس إلى دمشق، حيث حل الجمعة ضيفاً لدى الرئيس أحمد الشرع في سوريا الجديدة. ويأتي الترحيب المبدئي من كون عباس الرئيس الشرعي، أو للدقة، الرسمي للشعب الفلسطيني الذي يجب أن يكون إلى جانب سوريا الجديدة في سيرورة بنائها ونهوضها. أما “لكن” الاستدراكية فتأتي من كون عباس ينتمي وللمفارقة الى نفس الطبقة التي انتمى إليها نظام آل الأسد “الأب والابن”، ومن هنا فإنه لا يستحق بالتأكيد تمثيل الفلسطينيين بشكل عام واللاجئين في سوريا بشكل خاص، بعدما تخلى عنهم لصالح آلة القتل الآسدية، بل وتبنى رؤية النظام وغطى ممارساته وجرائمه ضد من يفترض أنهم مواطنيه ورعاته.
الرئيس الرسمي
إذن حل محمود عباس، رئيس الدولة والسلطة ومنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، ضيفاً لدى الرئيس السوري أحمد الشرع وبالعموم يجب الترحيب بالزيارة من زاوية الدعم الفلسطيني الرسمي والضروري والمطلوب لسوريا الجديدة، مع المزاج الشعبي المؤيد الثورة السورية وسقوط نظام الأسد بين اللاجئين في سوريا والشعب الفلسطيني بشكل عام، رغم انحياز الطبقة السياسية-الفصائل- برمتها إلى نظام الأسد باستثناء حماس، قبل أن يضم مسؤول الحركة الفعلي بالداخل والخارج يحيى السنوار-رحمه الله- الحركة إلى القطيع الفصائلي الداعم للنظام وروايته عن المؤامرة الأممية المزعومة ضده وتبييض جرائمه بحق السوريين والفلسطينيين واللبنانيين والمنطقة بشكل عام.
من هنا يأتي مبدأ الترحيب ،كون عباس الرئيس الرسمي والملقاة على عاتقه مهمة تمثيل الشعب الفلسطيني والتعبير عن أرائه ومزاجه العام والدفاع عن مصالحه الوطنية والقومية، لكن يأتي الترحيب من هذه الزاوية فقط بينما من الزاوية الأخرى ومبدئياً ومنهجياً، بدا المشهد- الصورة صادماً حيث الرئيس أحمد الشرع الشاب الأربعيني والحيوي والمفترض أن يأخذ سوريا الجديدة نحو المستقبل، ومقابله رئيس تسعيني هرم مترهل آت من الماضي بالمعنى الحرفي والدقيق للمصطلح فلسطينياً وعربياً وسورياً ودولياً.
للمفارقة أيضاً ينتمي محمود عباس إلى نفس الطبقة التي ينتمي إليها نظام الاسد “الأب والإبن” الساقط التي فشلت في امتحان بل امتحانات الخبز والحرية والكرامة وبالطبع امتحان فلسطين، وعجزت عن بناء دول ومنظومات وسلطات حقيقية، وبالعكس أقامت كيانات أقرب إلى جمهوريات الموز في فلسطين وسوريا والعالم العربي، ما يعنى أننا مطالبين كفلسطينيين بمواكبة التغييرات والتحولات وبالاتجاه نفسه لجهة إسقاط الطبقة الفاشلة، وحتمية تشكيل قيادة انتقالية مصداقة تتمتع بدعم جماهيري واسع لمدة زمنية محددة – إلى حين انتخاب قيادة جديدة شابة وديموقراطية ودون احتكار كل المناصب والسلطات.
تخلي عن اللاجئين
هذا بشكل عام، أما فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، فعباس يمثلهم رسميا ومن حيث الشكل فقط كونه رئيس منظمة التحرير، وحتى الدولة رغم أنها استندت لحدود حزيران/يونيو 1967 دون الإصرار على حق العودة للاجئين الذى تنازل عنه عباس فعلياً، حيث تخلى عنهم لسنوات حتى قبل الثورة السورية مختصراً القضية والمنظمة والسلطة بالفلسطينيين في الداخل -الضفة وغزة- وبعد الثورة عجز عن حمايتهم أو حتى رفع الصوت عالياً ضد تنكيل نظام الاسد وقتلهم وتشريدهم وتهجيرهم ثم انتقل بالسنوات الاخيرة إلى التماهي التام مع رواية النظام الآخطر على القضية الفلسطينية حسب تعبير الشهيد ياسر عرفات.
بالسياق، لابد من التذكير بحقيقة أن نظام آل الأسد كان قد شن حرباً منهجية على منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين وحاول احتكار القضية للمتاجرة بها ضمن مقاربة تحالف الأقليات التي تبناها بسوريا والمنطقة، لكنه اصطدم بالعقل الجمعي الوحدوي للرئيس عرفات وقادة وجمهور الثورة الفلسطينية بشكل عام.
وعليه، وفيما يخص عباس، فهو لا يستحق بالتأكيد تمثيل اللاجئين في سوريا، مع الانتباه الى أن سفره لدمشق لم يقتصر على القيام بواجب داعم سوريا الجديدة، وإنما لاحتكار تمثيل الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئين وتحقيق مكاسب سياسية فئوية، وربما تكون عينه كذلك على عملية إعادة الإعمار وحصول شركات العائلة على نصيب منها كما فعل في العراق وليبيا وحتى إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي.
ذلك إضافة إلى جريمة السكوت عن تدمير المخيمات وتهجير أهلها في شطب لحق العودة وإزالته عن خدمة جدول الأعمال، وبالتالي خدمة إسرائيل بما في ذلك مخيم اليرموك باعتباره عاصمة الشتات اللجوء الفلسطيني، بينما انحاز اللاجئون بعقلهم الجمعي إلى سوريا التاريخية العظيمة لا النظام ولو من باب رد الجميل إلى إخوانهم السوريين، مقابل انحياز الطبقة الفصائلية كلها إلى جانب النظام.
في الأخير، باختصار وتركيز، ومع الترحيب بالمعاني والدلالات الرسمية لزيارة عباس إلى دمشق، لا بد من الإشارة إلى نأي اللاجئين بأنفسهم ووعيهم الجمعي عنها وعن الفصائل المهترئة الفاسدة والمترهلة التي باتت عبئاً عليهم، كما على القضية نفسها، وعليهم التحرك ورفع الصوت عالياً بظل الاجواء المؤاتية -بسوريا الجديدة- لنزع الشرعية والثقة عن الطبقة برمتها -سلطة وفصائل- والعمل على تشكيل أطر جديدة شبابية ديموقراطية ومنتخبة أيضاً.
ومن جهة أخرى عدم تجاهل ضرورة الانخراط بسيرورة بناء سوريا الجديدة كما فعل آباؤهم وأجدادهم قبل حقبة البعث وآل الأسد سيئة الصيت، مع تمتعهم بكامل حقوقهم زمن سوريا المدنية الديموقراطية بعد الاستقلال، ومن دون التخلي عن هويتهم وذاكرتهم الوطنية وإطلاق حملة إعادة بناء المخيمات ضمن جهود إعادة بناء سوريا الجديدة، والاندماج بالحياة بمستوياتها وابعادها المختلفة السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية الاجتماعية، ضمن قناعة راسخة مفادها إن سيرورة بناء سوريا الجديدة هي نفسها ولو طالت سيرورة العودة وتحرير فلسطين.
المدن
————————–
“ريفيّون” في دمشق/ فدوى العبود
الأحد 2025/04/20
تعكس الهشاشة التي يتسم بها الوضع السوري، خصوصاً عقب الانتهاكات في الساحل، فجوة ثقافية وسياسية بين السوريين، وهي ترتبط بلا شك بالشرخ الذي أحدثه نظام الأسد فانعكس تصدعاً لم ولن ترأبه إلا سنوات ربما توازي ثلاثة أضعاف فترة حكم الأب وابنه.
وإلى جانب هذا، ثمة صدع آخر، برز في الفترة الأخيرة على سطح الأحداث، وهو يظهر تعقيد المشكلة السورية. مثلاً، البث المباشر لسيدة دمشقية ترفع شكواها للإدارة، تطلب فيها إعادة “هؤلاء الذين لا يستحمون” إلى محافظاتهم. ومثال آخر، الصحافي الذي صرّح عبر التلفزيون بأن هؤلاء الريفيين القادمين من إدلب لا يجيدون التعامل مع دمشق. إضافة إلى فيديو يظهر فيها رجل من حي المزرعة يصرخ في وجه أحد عناصر القوات الحكومية الجديدة، ويبدو أن الأخير استفزّه بعبارة: نحن حررناكم. بدا الرجل غاضباً إذ شرح الضيم الذي عانته دمشق وراح يردد: أنت حررتني.
يبدو وكأن هناك لغتين، كأننا إزاء أهل بابل، حين طلب أحدهم حجراً فضربه الآخر بملاط، نتيجة قطيعة دامت 13 سنة بين المحرَّر أو الشمال وبين دمشق. برزت، هنا وهناك، سلوكيات تتنافى مع عادات أهل الشام، سلوكيات ذات طابع ديني حاد رفضها قسم كبير من السوريين، لكنها أظهرت أن الاختلاف قنبلة موقوتة بين طرفين لا يعرف بعضهما بعضاً.
لكن هذا ليس السبب الوحيد، بل هو في العمق، سياسي. ممارسات الأسد الأب وابنه أتت ثمارها، والغيوم التي تركاها أمطرت مياهاً كاوية على رؤوس السوريين ومواسم حياتهم. كما لا يخفى على أحد أن ما نراه هو نتيجة شرخ اقتصادي أيضاً.
أفقَر الأب، وابنه من بعده، الريف السوري ودمر استثماراته. إهمال القرى لا تغفله عَين، إذ يستطيع زائر الساحل مثلاً ملاحظة حجم الجور الذي لحق به، فأُهملت التنمية عمداً، كما تبين تقارير حديثة أن الحرائق التي انتشرت في الساحل السوري كانت مفتعلة وتهدف إلى تصحره، يضاف إليها إهمال الموانئ والتجارة. لم يعد شاطئ البحر في الساحل سوى استثمارات لعصابة الأسد.
وامتد الإهمال إلى التعليم، حتى أصبح الشاب، بمجرد إنهائه الثانوية، يتطوع في الكلية الحربية، ليتم ربطه بالقوات النظامية والمدافعين عن الأسد، ما اضطر أبناء الساحل إلى هجره إلى التطوع في الجيش والعمل في دمشق. فهؤلاء الذين هُمّشت قراهم، وفدوا ليحيطوا بالقصر الجمهوري. ولم يقتصر الزحف العشوائي على وسط المدينة التي توزّعتها بسطات (الدخان والمشروب والبسكويت) إضافة إلى الأكشاك (الكولبات) التابعة للقوات الأمنية. بل كانت المدينة في عهد الأسدَين، أيّ شيء سوى مدينة. تحولت إلى سجن كبير.
هذا الموقف من الريف وأبنائه جذّره الأسد. والشرخ الذي بدأ اقتصادياً، تحول قطيعة ثقافية. فصار يُنظر إلى ابن الريف باعتباره طارئاً على المدينة بعاداته وثقافته وسلوكياته، وسرعان ما تحول هذا الموقف سياسياً، وظهر في رفض القادمين، واصطدام ثقافات الناس ورؤاهم وتصوراتهم للحياة.
لكن الرفض هنا شديد التعقيد. فالرافضون أو المتوجسون من السلطة الجديدة، والتي حلّت كسلطة أمر واقع، يعتبرونها غير دستورية كونها غير منتخبة، وبعض قراراتها وأدائها وضع البلاد عند منعطف صعب، سواء في الحياة اليومية، أو في المصير السياسي والاقتصادي بعيد المدى، ناهيك عن مظاهر السلاح في أيدي أشخاص لا تُعرف لهم صفة رسمية محددة. ولعلهم، بازدراء الريفيين، يعبّرون عن خوفهم على “مدينتهم” من سلوكيات وافدين جدد عاشوا لسنوات في مناطق أقرب إلى اللون الواحد، دينياً وسياسياً وثقافياً، ويشكّك بعض أبناء العاصمة في أن يتمكن هؤلاء من إدارة مدينة عريقة وضخمة وفسيفسائية مثل دمشق.
أما المرحبون بالسلطة الجديدة، فرأوا في سلوكيات مهاجمي هؤلاء الريفيين القادمين، وقاحة وتعديًاً. إذ بدا الحارس الحكومي ضعيفاً وهو يحاول التهدئة، معتذراً عن عباراته التي انفلتت في لحظة غضب، حسب تعبيره. وبدا الرجل الآخر شرساً وموتوراً في رأي الكثير من المتابعين، فكتب أحدهم: “أي نعم نحنا حررناك، ولازم تحترم هالناس اللي بذلت أرواحها مشان يطلع صوتك”، وذكّر المعلق بأحداث مشابهة، كمديرة إحدى المدارس التي قالت “بدها تربي كل الطلاب القادمين من الشمال، بكفي استفزاز حتى ما تصير ردود الأفعال مؤلمة لكم”.
تنقسم الآراء بين الرافضين لسلطة الأسد الذي كان حكُمه، في جوهره، ريفياً، وجعل دمشق مدينة موتى ومرتعاً لرجال ضخام بلحى مخيفة يُعرفون بالشبيحة، ولغرباء يضربون أنفسهم حتى يسيل الدم من رؤوسهم وصدورهم… وبين الرافضين للسلطة الجديدة، الذين يرون في دوائرها غرباء آخرون يهددون روح المدينة والإسلام المعتدل، إذ أصبحنا نسمع بالأمير أو الشيخ في تكرار للمأساة ذاتها.
قبل تحرير دمشق، كانت هناك لوحة رخامية تلفت انتباه الزائر بقطعها السماوية ولونها الذهبي. بدت وكأنها تتحدى الزمن، إذ يقف فيها الأسد الأب محاطاً بالفلاحين وأطفالهم في حقول ذهبية ينظرون للأفق فرحين، يقبضون بأيديهم على حزمة من القمح الذهبي، بينما يلوح الأسد بيده: “دمشق ترحب بكم”.
ظلت هذه اللوحة برهاناً واضحاً على عمق الفجوة بين الكذبة وبين من يصدقها. لقد أفقر الأسد “راعي الفلاحين”، هؤلاء، وتركهم رهائن الفقر والفاقة ممهّداً الأرض لابنه الذي محا بيوتهم وبساتينهم بالبراميل التي ستلقى على أبنائهم بعد سنوات.
الأرجح أن لا ريف متخلّفاً بالضرورة، ولا مدينة متحضّرة بالتعريف. سوريا اليوم وريثة دمار أخلاقي وثقافي واقتصادي طاوَل الريف والمدينة معاً. ولطالما كانت الأرياف السورية، من الرستن وحتى دير الزور والساحل السوري، حواضر عِلم ومعرفة، فتحولت في عهد الأسدَين منبعاً للتطرف والجهل والدماء… والكل ينتظر ما سيحمله الغد.
المدن
———————————-
حل “لواء العودة”… هل تبدأ دمشق حملة توحيد الجيش السوري؟/ حايد حايد
لا يمكن اعتبار ما حدث مع قوات العودة نموذجا قابلا للتعميم
آخر تحديث 21 أبريل 2025
شكّل حل اللواء الثامن، بقيادة أحمد العودة، في 13 أبريل/نيسان، نقطة تحول بارزة في المشهد الأمني السوري، إذ أزاح الرئيس المؤقت أحمد الشرع خصمه الأبرز في الجنوب، وفتح المجال أمام دمشق لتعزيز قبضتها على محافظة درعا.
وربط مراقبون هذه الخطوة بزيارة الشرع الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تجمعها بالعودة علاقات وثيقة. وعلى الرغم من أن التوافق الإقليمي ساهم في تسهيل العملية، فإن العامل الحاسم كان في الاستراتيجية الميدانية المحكمة التي انتهجتها دمشق.
فقد اتبعت الحكومة الانتقالية نهجا بات مألوفا بالنسبة لها، فبادرت إلى بناء مراكز قوة بديلة، ثم شرعت في عزل اللواء وإضعافه بشكل تدريجي، قبل أن توجه الضربة النهائية في الوقت المناسب، عبر مزيج مدروس من التهديد العسكري والضغوط المجتمعية. ثم تكللت هذه المقاربة باتفاق تفاوضي أدى إلى تفكيك اللواء دون أن تندلع مواجهات دامية تُذكر.
ويحاكي هذا النهج إلى حد كبير أسلوب “هيئة تحرير الشام” في تصفية خصومها بإدلب ومناطق الشمال السوري، ما يطرح تساؤلا جوهريا: هل تعتزم دمشق تطبيق الآلية ذاتها لاستيعاب بقية الفصائل المسلحة، التي تخضع شكليا لوزارة الدفاع، ضمن هيكل القوات النظامية الخاضعة بالكامل للدولة؟
تصاعد التوترات والانهيار
وكان اللواء الثامن قد حافظ، كغيره من الفصائل التي وافقت على الاندماج تحت قيادة وزارة الدفاع، على درجة غير مسبوقة من الاستقلالية في اتخاذ القرار، ولكنه انفرد بموقفه الصارم الرافض لتمركز أي قوات غير محلية موالية لدمشق في معقله بمدينة بصرى الشام.
وازدادت التوترات حدة بعد فشل المفاوضات المتعلقة بدمج اللواء في البنية العسكرية الرسمية، إذ تحولت الخلافات بشأن توزيع الرتب، وترسيم مناطق النفوذ، وتحديد الصلاحيات، إلى أزمة ثقة متفاقمة، حالت دون ترسيخ نفوذ دمشق في درعا.
وانتهجت الحكومة الانتقالية، على غرار “هيئة تحرير الشام”، سياسة القضم التدريجي لنفوذ اللواء، من خلال عزله وتوسيع شبكة تحالفاتها المحلية. وجاءت الخطوة المفصلية بتعيين بنيان أحمد الحريري- وهو من أبناء المنطقة وينتمي إلى عائلة ذات وزن عشائري- على رأس الفرقة العسكرية في المحافظة، ما أفضى إلى تحييد مجموعات كانت تشكل ركيزة أساسية في قوة العودة.
وفي مسعى موازٍ، اخترقت دمشق معقل العودة ببصرى الشام بدعمها للمنافس المحلي بلال الدروبي، الذي كُلّف بإنشاء خلية تابعة للأمن العام، بهدف تقويض هيمنة العودة وتعزيز حضور الدولة في المنطقة.
وقد أسفرت هذه الإجراءات، إلى جانب عوامل أخرى، عن تآكل ملحوظ في قوة اللواء الثامن، الذي انكمشت عناصره إلى ما بين 300 و400 مقاتل فقط، محاصرين في جيب بصرى الشام، ومعزولين تدريجيا عن حلفائهم الإقليميين وشبكات دعمهم الخارجية.
الضربة القاصمة
بلغت استراتيجية دمشق ذروتها في لحظة مدروسة، حين اختارت تفجير الأزمة في توقيت محسوب بعناية. وكانت الشرارة الأولى مواجهة مسلحة اندلعت بين قوات أحمد العودة وبلال الدروبي، تحت غطاء عملية لمكافحة المخدرات. لكن التحول الفاصل وقع عندما قُتل الدروبي خلال الاشتباكات، وهو ما أثار غضب أنصاره وأشعل موجة من المواجهات العنيفة.
اغتنمت دمشق الفرصة، فدفعت بـ1200 عنصر من قوات الأمن العام إلى أطراف بصرى الشام، في استعراض قوة ينذر بعملية عسكرية وشيكة. لكنها بدلا من اللجوء الفوري إلى السلاح، فتحت قنوات تفاوض مع وجهاء المنطقة. ولتعزيز الضغط الشعبي، تأخر دفن الدروبي، فيما استُخدمت المساجد لتنظيم مظاهرات تندد باللواء الثامن.
وتحت الضغط المجتمعي الغاضب، وفي ظل التهديد بتدخل عسكري، رضخ قادة اللواء الثامن للأمر الواقع. وفي 13 أبريل/نيسان، وافقوا على شروط تضمنت نزع السلاح، وتسليم السيطرة الأمنية لقوات الأمن العام، وتعيين قائد مؤقت للإشراف على دمج اللواء في هيكل وزارة الدفاع. وبذلك، طُويت صفحة النفوذ الذي مثّله أحمد العودة في المنطقة.
نموذج محتمل أم سابقة استثنائية؟
يمثل نجاح دمشق في تفكيك اللواء الثامن، باستخدام أدوات سياسية وميدانية تحاكي أساليب “هيئة تحرير الشام”، سابقة قد تُستنسخ في التعامل مع فصائل أخرى ترفض الاندماج الكامل في صفوف الجيش النظامي. غير أن مدى فعالية هذه الاستراتيجية يظل مرهونًا بثلاثة عوامل حاسمة: حجم الفصيل المستهدف، عمق ارتباطه الاجتماعي، ومستوى الشرعية التي تتمتع بها الحكومة المركزية في نظر المجتمعات المحلية.
ولا يمكن اعتبار ما حدث مع قوات العودة نموذجا قابلا للتعميم. فحين تقتضي الضرورة، قد تلجأ دمشق إلى الحسم العسكري المباشر لسحق أي مقاومة وفرض التفاوض بشروطها.
لكن، حتى إذا نجحت هذه المقاربة في توسيع رقعة السيطرة الحكومية، فإن الأزمة السورية العميقة تبقى عصية على المعالجة بتلك الوسائل وحدها. فالمطالب الأساسية للفصائل المعارضة المترددة– وفي مقدمتها اللامركزية، ورفض هيمنة “هيئة تحرير الشام” على القرار السياسي، والمطالبة بتقاسم فعلي للسلطة– تظل غير قابلة للتجاوز بالضغط والإكراه.
ويظل الغليان الاجتماعي كامنا تحت السطح، مثل بركان خامد، ما دامت قنوات الحوار الجاد مغلقة، وما دام دور الفاعلين السياسيين شكليًا. وعندما تُهمّش الأصوات، يصبح الانفجار مسألة وقت، لا نتيجة أيديولوجيات، بل حصيلة يأس متراكم، ونظام سياسي أخفق في أن يكون أداة تغيير حقيقية.
المجلة
—————————-
دمشق بين زيارتين/ إبراهيم حميدي
دمشق التي زرتها قبل أيام، ليست ذات المدينة التي زرتها غداة سقوط النظام
آخر تحديث 20 أبريل 2025
يوميات دمشق أشبه بالبورصة. يتأرجح نبض قلبها بين الصعود والهبوط. الورشة بدأت ومعركة الإعمار انطلقت. ستأخذ وقتا كي تستقر مؤشراتها لكنها ماضية. تحتضن المدينة رحابة، كي تتسع للأحلام والتوقعات.
دمشق التي زرتها قبل أيام، ليست ذات المدينة التي زرتها غداة سقوط النظام. أمور كثيرة تغيرت، وأخرى على حالها. توقعات واسعة ينتظرها السوريون، ولا يزالون يدورون في فضائها، سواء في نهاية العام الماضي أو في سنوات الجمر والحرب.
في نهاية العام الماضي، كانت المدينة تنام في ظلام وأهلها لا ينامون. كانت “الشام” في حالة احتفالية. فرح بسقوط النظام، فرح بعودة الكثيرين إلـى مدينتهم وعائلاتهم بعد انقطاع لسنوات أو عقود في عذابات المنفى. وقتذاك، كانت الرقصات تفيض على ضفاف نهر بردى وتعشعش في أشجار مدينة الياسمين. بين أغنية وأغنية، تصدح حنجرة بـ”ارفع راسك فوق أنت سوري حر”، ترحيبا بمنفيّ عائد، لا يقطعها إلا نشيد آخر للترحيب بعائد آخر وعناق آخر.
ارتبط الليل بالنهار. فوضى احتفالية. فائض عواطف. تواطأت المدينة مع عائديها وعانقتهم. لا وقت للمواقيت، لا سدود أمام فيضانات الدموع. لا إشارات مرور ولا سيارات شرطة ولا قواعد للسير والسهر. قبول بليل دون كهرباء. رقص في الظلام.
غزل للمدينة الهرمة. مديح لشقوق الشوارع والأبنية. احتضان للغازات الرمادية. لا وقت للمساءلة ولا نية للمحاسبة. قبول بفوضى البسطات والروائح في شوارع المدينة. الشيء الوحيد والهم الوحيد، هو الفرح بسقوط النظام. لحظات كان ينتظرها كثيرون لـ54 سنة أو 61 سنة. كل شيء مقبول أمام طغيان اللحظة التاريخية.
كانت الطموحات كبيرة، والأحلام واسعة والمشاعر متدفقة. كانت المواعيد تضرب مع التاريخ في قمة قاسيون، وكانت الندوات تعقد في مقاهيها. عاد السياسيون وعاد النشطاء والثوار. عاد معارضو “نظام الأسدين” لبناء نظام ما بعد الأسد. لكلٍ تصوره لمستقبل البلاد ودوره في بناء سوريا الجديدة. لكلٍ خريطته لبلاد رسمها كثيرون بدمائهم وجروحهم في ثواني العقد الدامي والعقود الثقيلة. لكلٍ أحلامه التي تخيلها في سقوف زنزاناتهم في “جمهورية الصمت” وثقوب خيمات النزوح في عراء موجات التهجير، ولكل ناجٍ من “قوارب الموت”، قارب يعبر فيه بسوريا من ضفة إلى أخرى.
دمشق مختلفة الآن. المدينة منظمة أكثر. الخدمات متوفرة أكثر. شرطة وأمن. مـؤسسات ووزارات. استعادت المدينة عاداتها. واستعاد أهلها إيقاعهم. لا احتفالات ولا أغنيات في المقاهي والشوارع. التراتيل الثورية اختفت. اتسعت رقعة النور والكهرباء في سماء المدينة ونوافذها. تسللت العادات إلى شوارع الشام.
الخدمات أفضل. المؤسسات تتحرك. الضوء يزيد زياراته إلى البيوت والقناديل. ضاقت المدينة بسياراتها. عناصر شرطة ينظمون حركتها. إشارات المرور استعادت أنوارها. يستجيب سائقون ومارة لأوامرها.
الطوابير موجودة أمام صرافات الرواتب والأموال. موجودة في صناديق حديدية أمام الأفران. تقدم خدماتها للجائعين وللفقراء. أما طوابير الباحثين عن تسويات لوضعهم الأمني، فلم تعد موجودة كما كان الحال في نهاية العام الماضي.
هموم الناس عادت إلى الأرض. غلاء المعيشة. توقف رواتب المتقاعدين، تعليق عمل موظفين في القطاع العام. وعاد القلق من أوضاع أمنية في محيط دمشق وغرب سوريا وجنوبها. التوقعات كانت أوسع من الإمكانات. الأحلام أسرع من الزمن. اختبارات عدة في الأسابيع الماضية أعادت الناس إلى الأرض. بلاد منهكة منهارة ومحاصرة، لن تنهض في أشهر. لا تكفي صورة أمام “السيف الدمشقي” للإفلات من طعنات “سيف العقوبات” الأميركي.
هكذا بدت دمشق من تحت. أما من فوق، فأصبحت ملامحها واضحة. الإعلان الدستوري صدر. النظام السياسي تبلور. إنه نظام رئاسي وفترة انتقالية لخمس سنوات. الحكومة تشكلت. “هيئة تحرير الشام” حافظت على الحقائب السيادية، وتركت حقائب أخرى إلى تكنوقراط دون ثقل سياسي، ضمنت وزراء من جميع المكونات، عرقية ودينية وطائفية، من دون محاصصة طائفية. ستستكمل الصورة بتشكيل الهيئة التشريعية.
الرسالة إلى السياسيين والطامحين في السياسة بينة. صدرت في “يوم النصر” في 29 يناير/كانون الثاني، وهي حل جميع الأجسام الثورية، العسكرية والسياسية والمدنية. إذن، لا مكان لأحزاب سياسية وتكتلات سياسية.
الأولوية من فوق، هي لتوفير الأمن وتحسين الاقتصاد. توفير الأمن بحل الفصائل ودمجها بوزارة الدفاع الجديدة بلغة الحوار أو نار السلاح، أو تسويات. هذا ما حصل. بات المسيحيون يحرسون مناطقهم والدروز والأكراد، تحت “مظلة الدولة”. أما العلويون في الساحل، فمسـألة أخرى. تمرد الفلول، كان اختبارا داخليا وإيرانيا للحكم الجديد. بدأ بتمرد عسكري مبرمج قتل فيها عناصر من “الأمن العام” وانتهى بفصول دامية من القتل لا تزال جروحها مفتوحة.
تشكيلة الحكومة وخيارات الوزراء تدل على أن تحسين الاقتصاد أولوية، والمفتاح في رفع العقوبات. دول عربية وإقليمية وأوروبية مدت يدها إلى دمشق. كل دول حليفة لدمشق، مستنفرة لتحريك العجلة بسرعة. العقوبات الأميركية تضع سقف المساهمات في إطلاق عجلة الاقتصاد. واشنطن منقسمة بين تيارين: واحد، يرى الحكم السوري الجديد “قاعديا”. ثان، مستعد للانخراط مع الحكم الجديد وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.
أصحاب التيار الثاني، قدموا إلى دمشق قائمة بثمانية مطالب، بعضها تجد دمشق صعوبة أو استحالة في قبولها، يتعلق بالنشاط السياسي للفصائل الفلسطينية واستهداف شخصيات في سوريا. ردت دمشق برسالة خطية على المطالب الأميركية، وهي تراهن على زيارة وزارية إلى واشنطن لحضور اجتماعات “البنك الدولي” وإلى نيويورك لرفع العلم الجديد في أروقة الأمم المتحدة.
الزمن كالسيف، الشعب يقدر “معجزة التحرير”، والجيوب الفارغة تنتظر المعجزات. جرس الانذار يدق الأبواب. رجال أعمال ووزراء قرروا ترك أشغالهم ومصالحهم في الخارج، للعودة للمساهمة في تفكيك القنابل المزروعة في المؤسسات، وفك العقد في الهيئات، والبحث عن خيارات بديلة للعيش تحت “سيف العقوبات”، ورشة كبيرة كشفت حجم المجازر التي ارتكبها النظام في المؤسسات الحكومية.
تكنوقراط وخبراء في رأس الوزارات. لكن هذه الوزارات والمؤسسات تركها موظفون كثر. في المقابل، انضم إليها موظفون من إدارات إدلب ومناطق النزوح. بين استبعاد موظفين والإقامات المؤقتة لـ”الزائرين” تكون ساعات العمل والانجاز قصيرة، وتكون ذخيرة “خوض الحرب للالتفاف على العقوبات” قليلة.
خلطة تراجع الوضع الاقتصادي أو عدم تحسنه، وتهديدات الوضع الأمني، ينتظرها متربصون في الداخل والخارج للانقضاض في اختبار جديد. وهناك جهد لدى أصحاب القرار في نزع فتيل هذه القنبلة.
الوضع في شوارع دمشق وكنائسها وجوامعها ومقاهيها، مريح أكثر مما هو على وسائل التواصل الاجتماعي. مقلق أكثر مما يبدو على السطح في قصائد المداحين. خطوة تنشر الارتياح كما حصل لدى حماية “الأمن العام” الأعياد المسيحية في دمشق والزيارات السياسية الرفيعة. إشاعة تعمم الخوف، كما حصل لدى تداول أخبار عن عمليات خطف في العاصمة، أو تحذيرات عدم السفر الصادرة من أميركا وبريطانيا أو منع عواصم غربية لدبلوماسييها من النوم في دمشق.
خبر يشجع مهجرين على العودة، وآخر يدفع شبابا للتفكير في الهجرة. تتأرجح قلوب السوريين بين يوم وآخر. التحديات كثيرة. الورشة تشكلت وخطة الإعمار بدأت ومعركة تفكيك الألغام والقبض على الأحلام انطلقت.
المجلة
—————————————-
كي لا تكون تركيا إيران أخرى في سوريا/ إياد الجعفري
لا نعرف إلى أي حد يمكن الرهان بإيجابية على أن الدروس المستقاة من التجربة الإيرانية مع نظام الأسد في سوريا، واضحة المعالم في أذهان صنّاع القرار في أنقرة ودمشق، اليوم. إذ يمكن تسجيل مؤشرات إيجابية بهذا الصدد. في الوقت ذاته، يمكن التقاط مؤشرات أخرى مقلقة. لكن ما يمكن الرهان عليه بصورة أكيدة، أن استنساخ تجربة طهران مع “سوريا الأسد”، في مشهد العلاقة التركية- السورية الراهنة، لن يؤول إلا إلى النتائج ذاتها التي آلت إليها التجربة الإيرانية.
أما مناسبة هذا الكلام، فهي تلك الزيارة المهمة التي قادها وزير التجارة التركي، عمر بولات، على رأس وفد ضم رجال أعمال وصناعيين أتراك، إلى العاصمة دمشق، نهاية الأسبوع الفائت. حيث التقى بوزراء الاقتصاد والمالية والنقل، وعقد لقاءً حوارياً مع تجار وصناعيين سوريين، ليتحدث عن رغبة بلاده في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا.
يشكّل المفصل الاقتصادي في العلاقة السورية- التركية، واحداً من أكثر مفاصل تلك العلاقة حساسية، وتأثيراً، في استدامتها بصورة إيجابية، مستقبلاً، من دون أن نتجاهل أهمية المفاصل الأمنية والعسكرية والسياسية، أيضاً. إلا أن الاقتصاد قد يكون “قبلة الموت” لهذه العلاقة، على المدى المتوسط، أو بالعكس.
وبالعودة إلى الدروس المستقاة من التجربة الإيرانية مع “سوريا الأسد”، في 14 سنة الأخيرة، يمكن إيجاز أبرزها، بالنظرة الإيرانية إلى سوريا، بوصفها ساحة لتعزيز قدراتها التنافسية في الإقليم، من زاوية أمنية- عسكرية، بصورة أساسية. وهو ما حوّل سوريا، بصورة متصاعدة، إلى مساحة اشتباك إسرائيلية- إيرانية، وإيرانية- أميركية، أضرّت بشدة بمصالح السوريين. ومن ثم، كان الرهان الإيراني على التشكيلات الميليشاوية، والعمل على تعزيز استقلاليتها. أما على الصعيد الاقتصادي، فكانت النظرة الإيرانية لسوريا ذات ثلاثة وجوه، ساحة للمغانم الاقتصادية السهلة لاسترداد الديون، وسوقاً لتصريف المنتجات الإيرانية، ومصنعاً للكبتاغون. وفي الوجه الأول، ضاربت طهران على مصالح بشار الأسد الشخصية، فكانت تنازعه في القطاعات التي حاول احتكارها لصالحه، فظهر تضارب المصالح هذا جلياً في السنتين الأخيرتين. كذلك، عرقلت طهران معظم محاولات الأسد لاستجلاب دعم مالي خليجي، عبر تقصّد إظهار نفوذها عليه. وقد تسبب النفوذ الإيراني في إبقاء العقوبات المشددة سارية على سوريا. فأدى مجمل العوامل السابقة إلى تعزيز أسباب الانهيار الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق في البلاد، وصولاً إلى خروج أصوات علنية في الحاضنة الموالية للنظام، تهاجم إيران مباشرةً، وتحمّلها مسؤولية ما وصل إليه السوريون من فقر وضيق حال.
اليوم، تنظر تركيا إلى سوريا أيضاً، بوصفها ساحة لتعزيز قدراتها التنافسية في الإقليم، لكن من زاوية مختلفة، هي الاقتصاد. ونستطيع أن نراهن على أن صراعاً عسكرياً مباشراً بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية، لن يقع قريباً. وأن أنقرة ستكون أكثر حرصاً على استقرار سوريا، بالمعنى الأمني، لأسباب مرتبطة باستقرارها هي. لكن في البعد الفصائلي، نجد مؤشرات مقلقة، بالفعل. فالفصائل المقرّبة من تركيا، في “الجيش الوطني” بشمال غرب سوريا، لا تزال تتمتع بهامش استقلالية ملحوظ، رغم اندماجها الرسمي في جيش موحد، تحت قيادة “هيئة تحرير الشام”. ويمكن الذهاب إلى أن تفكيك عقدة الفصائلية يتطلب مزيداً من الوقت والعمل الحثيث والهادئ. فليس من مصلحة تركيا وجود مناطق نفوذ متصارعة على التراب السوري. كذلك في السياسة، يبدو النهج التركي متوازناً إلى حدٍ ما. وتبقى العقدة الرئيسية في الاقتصاد.
بُعيد الأيام الأولى من سقوط نظام الأسد في كانون الأول الفائت، عرفت الأسواق السورية فيضاناً من البضائع التركية منخفضة الجودة والسعر، فتلقفها المستهلكون السوريون بترحاب كبير بعد سنوات من ضيق الخيارات وغلائها، فيما تلقى المنتجون السوريون آثارها السلبية. وتم الحديث عن إغلاق عدد كبير من المنشآت الإنتاجية جراء العجز عن المنافسة. ولتدارك المشهد قبل انهيار آخر المؤسسات الإنتاجية المحدودة المتبقية في البلد، إلى جانب الحاجة لتمويل الخزينة شبه المفلسة، أصدرت حكومة تصريف الأعمال السورية، مطلع العام الجاري، قائمة رسوم جمركية، شكّلت صدمة للتجار الأتراك. فتشكوا منها علناً. ودخل المسؤولون في أنقرة على خط الضغوط، وصولاً إلى الإعلان من جانب واحدٍ، تركي، عن تخفيض الرسوم الجمركية على 269 سلعة تركية، قبل أن ينفي الجانب السوري هذا الخبر. قبيل ذلك وخلاله، كان المسؤولون الأتراك يتحدثون عن سوريا، بصيغة الغائب. فتحدثوا عن اتفاقات مزمعة في التجارة الحرة، وترسيم الحدود البحرية، ومسائل أخرى، تبدى لاحقاً أن السلطات السورية في دمشق، استطاعت النفاذ من الضغوط بخصوصها، وتجنبت تقديم تنازلات مباشرة فيها.
ومنذ أسابيع، أصبحت تصريحات المسؤولين الأتراك في الشأن السوري أكثر توازناً وضبطاً. وجاءت زيارة وزير التجارة التركي إلى دمشق، ولقاؤه مع الوزراء المعنيين بالحكومة السورية الجديدة، مرفقة بتصريحات مطمئنة، إلى حدٍ ما. من ذلك إشارة وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، إلى تعزيز الصناعة المحلية وحماية المنتج المحلي. وهي إشارة قابلها نظيره التركي، بالحديث عن حل الإشكالات التي تعترض عمل الصناعيين والتجار، بما يضمن تحقيق النمو والازدهار في سوريا الحرة الجديدة، حسب وصفه.
وهكذا نأمل أن تُترجم تلك التصريحات المطمئنة إلى سياسة تركية، ترى في سوريا شريكاً لا تابعاً، واقتصادها مساحة لتقاطع المصالح والمكاسب المتبادلة، لا ساحة خلفية لتصريف المنتجات التركية الكاسدة، والمكاسب الاقتصادية السهلة على حساب مصالح السوريين. لأن ذلك يعني، في المستقبل المتوسط وليس البعيد، انفضاض الحاضنة المؤيدة اليوم للسلطة في دمشق، ولتحالفها القائم مع أنقرة، من حولها. كما حدث عشية سقوط نظام الأسد قبل بضعة أشهر فقط.
المدن
——————————
يد ممدودة بحذر.. ما هي دلالات التوجه الروسي الجديد نحو سوريا؟/ أحمد العكلة
21 أبريل 2025
في تحول يعكس قبولًا دوليًا متزايدًا للواقع السياسي الجديد في دمشق، أعلنت روسيا عن استعدادها الكامل للتعاون مع حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وجاء الموقف الروسي ليؤكد رغبة موسكو في إعادة تشكيل علاقاتها مع سوريا ضمن إطار أكثر مرونة، يستوعب التحول السياسي الذي قاد إلى صعود الشرع إلى السلطة.
موسكو تبحث عن تموضع جديد
روسيا، التي كانت الحليف الأبرز لنظام بشار الأسد، تدرك اليوم أن استمرار نهج الإنكار السياسي لم يعد مجديًا في ظل التغيرات على الأرض. ومع بروز حكومة جديدة في دمشق، فإن موسكو تسعى إلى التموضع من جديد كشريك سياسي واستراتيجي، يضمن مصالحها في سوريا من دون أن تصطدم مع المتغيرات الحاصلة.
في تعليقه على ما يُثار حول دعم روسيا لمرحلة سياسية جديدة في سوريا، وإن كان ذلك يمثل تحوّلًا استراتيجيًا في السياسة الروسية، أوضح رامي الشاعر، المقرب من دوائر صناعة القرار السياسي في روسيا، في حديث لـ”الترا سوريا”، أن “العلاقات الروسية – السورية علاقات تاريخية واستراتيجية، وقد حافظت على قوتها وعمقها على مدار عقود طويلة. روسيا حريصة جدًا على تطوير هذه العلاقات، وكذلك القيادة السورية الحالية تشاطرها هذا الحرص”.
وأضاف الشاعر أن “أمير دولة قطر نقل مؤخرًا، خلال محادثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو، رسالة من الرئيس السوري أحمد الشرع، أكّد فيها الأخير تمسكه بالعلاقة مع روسيا وحرصه على تعزيزها، واصفًا إياها بأنها علاقة استراتيجية”.
وتابع: “روسيا تقدم اليوم، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، مساعدات مهمة في مجال الطاقة، في وقت تعتبر فيه أزمة الطاقة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد. كل المؤشرات تؤكد أن العلاقات الروسية – السورية ستحافظ على طابعها الاستراتيجي، خاصةً أن موسكو تؤكد دائمًا على أهمية احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها”.
وأشار الشاعر إلى أن “الموقف الروسي ثابت ومبدئي، قائم على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن أن يتغير، خصوصًا تجاه دولة مثل سوريا التي تجمعها بروسيا علاقات راسخة منذ أكثر من نصف قرن. هذه العلاقات لا يمكن أن تؤثر فيها أي عوامل خارجية أو متغيرات إقليمية أو دولية”.
وأكد أن “روسيا أعلنت رسميًا دعمها للقيادة الحالية برئاسة أحمد الشرع، وأن القيادة السورية تثمّن الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وعلى رأسها أهمية استعادة الجولان المحتل”.
وختم الشاعر تصريحه بالقول: “أنا على يقين بأن القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع ستلقى دعمًا واسعًا من روسيا والدول العربية والبلدان الصديقة، في مساعيها لتحرير الأراضي العربية المحتلة، واستعادة الجولان، وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ولا يجوز التشكيك بوطنية القيادة الحالية في سوريا، كما لا يجوز إطلاقًا افتراض أن روسيا قد تغيّر سياستها تجاه دمشق، بل على العكس، هي ماضية في تعميق هذه العلاقة الاستراتيجية”.
قطر لاعب توافقي
اللقاء بين الرئيس الروسي وأمير قطر كان فرصة لإعادة رسم ملامح التعاون في الملف السوري، حيث عبّر الطرفان عن أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، بالتوازي مع دعم عملية سياسية تقود إلى استقرار دائم. ووفق مصادر دبلوماسية، فإن بوتين أبدى استعداد روسيا للعمل مع حكومة الشرع “بروح من الواقعية السياسية” تؤسس لشراكة جديدة، تشمل ملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وإعادة التوازن إلى المشهد السوري.
وتواصل قطر لعب دور الوسيط الفاعل في الملف السوري، مستفيدةً من قدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية. وبحسب التحليلات، فإن الدوحة ترى في الإدارة السورية الجديدة فرصة لتوحيد المواقف العربية تجاه سوريا، وإعادتها إلى الصف العربي ضمن رؤية تتجاوز الماضي، وتفتح الباب أمام عملية إعادة بناء سياسي ومؤسساتي.
من جهته، يقلل الخبير في العلاقات الدولية، د. محمد الإسماعيل، من أهمية الدور الروسي في سوريا، وذلك بسبب ما أسماه الانفتاح السوري على الغرب. ويضيف في حديث لـ”الترا سوريا”، أن “الرئيس أحمد الشرع ربما بحاجة إلى روسيا من أجل خلق توازنات في المنطقة، ولكن الشعب السوري لن ينسى المجازر التي ارتكبتها روسيا، بدءًا من الغوطة إلى حلب ثم حمص وإدلب، وتهجير الملايين، ناهيك عن الطلبات الأوروبية بإخراج الروس من سوريا مقابل الدعم المالي والضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات”.
ولفت إلى أن الدولة السورية “سوف تتعامل مع روسيا من باب الحفاظ على الحد الأدنى من المصالح الروسية في سوريا، مقابل شروط ربما تبدأ بتسليم الأسد، وهو ما لن تنفذه روسيا. لذلك، ربما تكون هناك شروط اقتصادية لا أكثر، لأن الاتفاقات العسكرية مع روسيا، بهدف خلق توازن مع إسرائيل، لا يمكن أن تُطبق في ظل التوجه الحكومي السوري نحو الانفتاح والشراكة مع الدول الغربية”.
تحديات المرحلة المقبلة
رغم الترحيب الدولي الأولي بالحكومة الجديدة في دمشق، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة، تبدأ بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ولا تنتهي عند ضرورة إطلاق مصالحة وطنية واسعة تشمل كافة الشرائح. كما أن قدرة هذه الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين روسيا والدول الغربية، وكذلك التعامل مع النفوذ الإيراني المتجذر في بعض مفاصل الدولة، ستكون عوامل حاسمة في نجاح المرحلة الانتقالية.
إعلان موسكو عن استعدادها للتعاون مع حكومة أحمد الشرع قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الملف السوري، تقوم على الواقعية السياسية بدلًا من المعادلات الصفرية. ومع انخراط قطر في هذا المسار، تبدو الفرصة متاحة لتأسيس شراكة إقليمية ودولية تدعم الاستقرار في سوريا، وتمنح السوريين فرصة حقيقية للخروج من نفق الأزمة الطويلة.
الترا سوريا
———————-
بين الحقول والمنازل.. مخلفات الحرب تحاصر حياة السوريين بصمت
21 أبريل 2025
تواصل الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة حصد الأرواح في سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط غياب خطة حكومية شاملة لإزالتها. وفي ظل انتشارها في أراضٍ زراعية ومناطق مأهولة بالسكان، تواجه جهود عودة اللاجئين وإعادة الإعمار تحديات قاتلة تُهدّد حياة المدنيين، ومصدر رزقهم الوحيد.
تشير وكالة “أسوشيتد برس” في افتتاحية تقرير لها إلى أنه قبل أربعة أشهر، كان سليمان خليل (21 عامًا) يجني الزيتون برفقة صديقين في بستان بريف إدلب السوري، دون أن يدرك أن الأرض التي يقفون عليها تخفي تحتها بقايا قاتلة من الحرب، قبل أن يشاهدوا لغمًا ظاهرًا فوق سطح التربة.
وأضافت الوكالة أن تحت وطأة الذعر، حاول خليل ورفيقاه الهرب، لكنه داس على أحد الألغام فانفجر. بينما فر أصدقاؤه باحثين عن سيارة إسعاف، وسط اعتقاد خليل المصاب أنهم تركوه ليموت.
يقول لـ”أسوشيتد برس”: “بدأت أزحف، ثم انفجر اللغم الثاني”، وأضاف: “في البداية، ظننت أنني متّ. لم أعتقد أنني سأنجو”. أُصيبت ساق خليل اليسرى بجراح بليغة في الانفجار الأول، بينما بُترت ساقه اليمنى من فوق الركبة في الانفجار الثاني.
ويوضح خليل في حديثه أنه استخدم قميصه لربط الجرح ووقف النزيف، وراح يصرخ طلبًا للمساعدة، حتى سمعه جندي قريب وهرع لإنقاذه. قال خليل، وهو جالس على فراشه وساقه المبتورة لا تزال ملفوفة بشاش أبيض بعد مرور أشهر على الحادثة: “كانت هناك أيام لم أرغب فيها بالعيش”. وينحدر خليل من قرية قميناس جنوب محافظة إدلب، وهو شاب ينتظر تكليل خطوبته بالزواج، ويحلم اليوم بالحصول على طرف صناعي ليعود إلى العمل ويعيل أسرته.
ورغم أن الحرب السورية، التي امتدت لنحو 14 عامًا، انتهت مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، إلا أن مخلفاتها ما تزال تقتل وتشوّه. ووفقًا لـ”INSO”، وهي منظمة دولية تُعنى بتأمين العمل الإنساني، فإن الألغام والذخائر غير المنفجرة تسببت منذ ذلك التاريخ بمقتل 249 شخصًا، بينهم 60 طفلًا، وإصابة 379 آخرين.
كما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير حديث إن الألغام والذخائر، التي استخدمتها بشكل واسع أطراف الحرب السورية منذ عام 2011، تلوّث مناطق شاسعة من البلاد، لا سيما تلك التي أصبحت متاحة فقط بعد الإطاحة بنظام الأسد، ما أدى إلى ارتفاع في أعداد الضحايا.
“قد نحتاج إلى سنوات طويلة لإزالتها كلها”
حتى قبل سقوط النظام، تسببت الألغام والذخائر في إصابة وقتل المدنيين العائدين إلى قراهم أو أراضيهم الزراعية. ووفقًا للباحث الأقدم في النزاعات لدى “هيومن رايتس ووتش”، ريتشارد وير، فإنه “من دون جهود تطهير وطنية عاجلة، فإن المزيد من المدنيين العائدين لاستعادة حياتهم وحقوقهم وأراضيهم سيتعرضون للإصابة أو الموت”.
وبحسب “أسوشيتد برس”، يُقدر الخبراء أن عشرات الآلاف من الألغام لا تزال مدفونة في سوريا، وخصوصًا في مناطق كانت جبهات قتال سابقة مثل ريف إدلب.
وقال عضو وحدة إزلة الألغام التابعة لوزارة الدفاع السورية أحمد جمعة: “لا نملك حتى رقمًا دقيقًا”، وأضاف موضحًا أن تطهير الأراضي من مخلفات الحرب “سيستغرق الأمر سنوات طويلة لإزالتها”.
وكان جمعة يتحدث للوكالة الأميركية وهو يمسح أرضًا زراعية شرق معرة النعمان بجهاز كاشف، مشيرًا إلى لغم مضاد للأفراد ظاهر على سطح التراب الجاف. وأضاف: “هذا النوع يمكنه بتر ساق. علينا تفجيره يدويًا”.
أضرار نفسية ومعيشية مستمرة
لا يزال القطاع الزراعي مصدر الدخل الرئيسي في ريف إدلب، بحسب “أسوشيتد برس”، الأمر الذي يجعل وجود الألغام خطرًا يوميًا على السكان. فقد انفجرت قبل أيام فقط آلة زراعية في المنطقة، مما أدى إلى إصابة عدد من العمال بجراح بالغة. وأوضح جمعة أن “معظم الألغام هنا تستهدف الأفراد والمركبات الخفيفة، مثل تلك التي يستخدمها المزارعون”.
ولفتت الوكالة الأميركية في تقريرها إلى أن وحدة نزع الألغام بدأت عملها فور سقوط نظام الأسد، لكنها دفعت ثمناً باهظًا. يقول جمعة: “فقد ما بين 15 إلى 20 من زملائنا أطرافهم، وقُتل نحو 12 منهم أثناء أداء مهامهم”.
وأضاف عضو وحدة إزالة الألغام أن الأجهزة المتقدمة القادرة على كشف العبوات المدفونة أو المصنعة يدويًا نادرة، مشيرًا إلى أن بعض الألغام لا تزال ظاهرة للعيان، لكن بعضها الآخر أكثر تطورًا ويصعب اكتشافه.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها أن الألغام لا تقتل وتُشوّه فحسب، بل تسبب كذلك أزمات نفسية دائمة، وتُسهم في التهجير، وفقدان الممتلكات، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة الانتقالية بتأسيس هيئة مدنية لإدارة ملف الألغام بالتنسيق مع “خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام”، وذلك بهدف توسيع وتنسيق جهود إزالة هذه المخلفات القاتلة.
“كل يوم هناك من يموت”
وفي ريف إدلب، تقول الوكالة الأميركية إن صلاح سويد كان يقف أمام قبر شقيقه محمد، وهو يعرض صورة له على هاتفه يظهر فيها مبتسمًا خلف كومة من الألغام التي فككها. وقال: “والدتي، كما أي أم، حذرته من الذهاب، لكنه ردّ قائلًا: إذا لم أذهب أنا، من غيري سيذهب؟ كل يوم هناك من يموت”.
كان محمد في الـ39 من عمره حين قُتل في 12 كانون الثاني/يناير أثناء نزع لغم في إحدى قرى إدلب. وكان سابقًا أحد عناصر الحرس الجمهوري السوري، متخصصًا في زرع الألغام وتفكيكها، ثم انضم لاحقًا فصائل إلى المعارضة خلال الثورة السورية، وكان يستخدم بقايا الذخائر في تصنيع أسلحة، بحسب “أسوشيتد برس”.
وقد عمل محمد حتى ما قبل مقتله مع وحدات تركية في مدينة أعزاز، مستخدمًا معدات متقدمة، لكنه كان بمفرده يوم مقتله. وأثناء تفكيك لغم، انفجر آخر كان مخفيًا تحته.
وتشير الوكالة الأميركية إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد، باتت قريته مليئة بالألغام، وبدأ بتفكيكها طوعًا استجابةً لنداءات الأهالي، حتى في أيام العطل حين تكون فرق نزع الألغام في إجازة. لكن رغم ذلك، ومع كل لغم ينجح أشخاص كمحمد في تفكيكه، تبقى أعدادٌ أكبر مدفونة في الأرض.
بالنسبة لجلال المعروف (22 عامًا)، فإن الأمر مختلف، كان الشاب يرعى ماشيته بعد ثلاثة أيام من سقوط نظام الأسد، عندما داس على لغم. سارع رفاقه إلى نقله للمستشفى، حيث بُترت ساقه اليسرى.
وقال من منزله وهو يتحسس طرف ساقه المبتورة: “أضفت اسمي إلى قائمة الانتظار للحصول على طرف صناعي، لكن لا جديد حتى الآن”، وأضاف “كما ترى، لا يمكنني المشي”، لافتًا إلى أن تكلفة الطرف الصناعي تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف دولار، وهو مبلغ لا يستطيع تأمينه، كما تقول “أسوشيتد برس” في نهاية تقريرها.
————————–
الاتحاد الأوروبي وسوريا: شروط تعجيزية أم فتح صفحة جديدة؟/ أحمد زكريّا
19 أبريل 2025
في تحول لافت، وإن كان محسوبًا، كشفت تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن ديناميكية جديدة في التعامل مع الملف السوري.
وبينما تشير هذه التصريحات إلى انفتاح أوروبي نسبي على الحكومة السورية الجديدة، إلا أن “الشروط الفنية” و”الخطوط الحمراء” التي تمت الإشارة إليها ترسم إطارًا مشروطًا لهذا الانفتاح، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة المتوقعة والضغوط الكامنة خلفها.
رسالة واضحة أم حذر استراتيجي؟
تعكس تصريحات كالاس، التي جاءت في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، موقفًا مزدوجًا: الرغبة في دعم استقرار البلاد وإعادة الإعمار، والحذر من منح شرعية كاملة للحكومة السورية الجديدة دون ضمانات ملموسة.
ويتجلى هذا الحذر بشكل واضح في الإصرار على “تقييم العملية حتى الآن”، وربط أي خطوات مستقبلية بـ”الالتزام بشروط فنية وخطوط حمراء”.
وقالت كالاس: “لم نرَ خطوات كثيرة من القيادة السورية الجديدة ولا يزال مستقبل سوريا هشًا للغاية، لكنه يبعث على الأمل”، مضيفةً: “اتفقنا على أننا سنقيّم العملية حتى الآن لأننا رفعنا بعض العقوبات”.
ولفتت إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعمل على اقتراح الخطوات التالية، مع مراعاة الشروط والخطوط الحمراء التي سنضعها أو الشروط التي يجب تحقيقها”. وزادت موضحة: “سنعمل على المواصفات الفنية هناك، ثم نعود إذا كنا مستعدين للموافقة والمضي قدمًا في هذه الخطوة”، مؤكدة على أن “إعادة إعمار سوريا تتطلب توفير الخدمات”.
إبراهيم خولاني، الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يفسر ذلك بالقول: “إن الحديث عن شروط وخطوط حمراء من الاتحاد الأوروبي يشير إلى أنهم ما زالوا مترددين في منح شرعية كاملة للحكومة الجديدة في دمشق، وهذا يعني أن هناك موقفًا حذرًا أو متوجسًا من المسار السياسي الجاري الآن، وأن هناك مخاوف من تكرار أنماط استبدادية أو التواءات سياسية قد تشبه ما كان عليه الوضع في عهد النظام السابق”.
وأضاف في حديثه لـ”الترا سوريا”: “توحي هذه التصريحات بأن الاتحاد الأوروبي يريد من الحكومة الجديدة التزامات ملموسة، قابلة للقياس والمراقبة، مثل احترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات السياسية، وإشراك أطراف أخرى كانت تعارض النظام السابق، وتوحي أيضًا بأن العقوبات ستظل أداة سياسية بيد الاتحاد الأوروبي للضغط على القيادة الجديدة وضمان ألا تنزلق مجددًا في ممارسات الاستبداد والتهميش، وألا تتبنى سياسات لا تتماشى مع المبادئ الأوروبية”.
بينما يفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام علاقة جديدة مع سوريا، فإنه يضع شروطًا صارمة قد تحدد مسار هذه العلاقة
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الشروط مجرد آلية للضغط على دمشق، أم أنها تعبر عن عدم ثقة كاملة في المسار السياسي الجديد؟ يبدو أن الإجابة تكمن في محاولة الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن دقيق بين تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار وضمان ألا تتحول هذه الجهود إلى مظلة لتعزيز سلطة غير مرغوب فيها، حسب تعبير خولاني.
هل التحول الأوروبي مرتبط بالموقف الأميركي؟
لا يمكن تجاهل الدور الأميركي في تشكيل الموقف الأوروبي، فعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بقدر من الاستقلالية في قراراته، إلا أن التنسيق الوثيق بين الجانبين، خاصةً في ملفات الشرق الأوسط، يجعل من الصعب فصل الموقف الأوروبي عن التوجهات الأميركية.
محمد السكري، الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يقول لـ”الترا سوريا”: “لا أعتقد أن هناك تحولًا في موقف الاتحاد الأوروبي، وإنما إعادة توضيح السياسات الأوروبية بما يخص متابعة وتقييم الوضع في سوريا، والتذكير بأن الرفع الجزئي للعقوبات مقترن بإحداث تغييرات مطلوبة بملفات التنوع والانفتاح على جميع المكونات السورية”.
وتابع: “وبلا شك يتأثر الاتحاد الأوروبي بالموقف الأميركي المتوجس، لكن يعتبر موقف الاتحاد أكثر تقدمًا من الجانب الأميركي، وخاصةً في ظل بناء الثقة مع الحكومة السورية والزيارات المتبادلة”.
وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي عزت الشيخ سعيد أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الاستقلالية في اتخاذ قراراته، خاصةً في مواقفه وسياساته الخارجية. ويقول: “لابد أن نذكّر بالمقولة المعروفة، التي تقول إن الاتحاد الأوروبي عملاق اقتصادي ولكنه قزم سياسي؛ بمعنى أنه يشغل دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي، لكنه ذو أداء سياسي ضعيف وتابع لمواقف الولايات المتحدة الأميركية”.
وأضاف لـ”الترا سوريا”، أنه لابد أن نذكر أيضًا التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، منذ أيام، حول تبعية دول الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة، حيث قال: “إن العديد من الدول الأوروبية كانت تفتقر إلى الحزم الكافي في معارضتها لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، ولو كانت أكثر استقلالية واستعدادًا لمواجهة قرارات السياسة الخارجية الأميركية، لربما أمكن تجنب الكارثة الاستراتيجية المتمثلة في غزو العراق”.
وقال الشيخ سعيد: “ما ذكرناه يدلل على أن الاتحاد الأوروبي افتقر سابقًا ويفتقر حاليًا لهذه الاستقلالية في اتخاذ قراراته، خاصةً في مواقفه وسياساته الخارجية، لذلك نرى هذا التردد في موقفه من سوريا وقيادتها الجديدة”.
وضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء
وتابع عزت الشيخ سعيد قائلًا: “كنا نأمل من الاتحاد الأوروبي دعم القيادة الحالية في سوريا، وهي تملك الكثير لتقدمه، في ملفات الأمن وبناء وإدارة الدولة وإعادة الإعمار وتدريب الكوادر في شتى المجالات، ورفع العقوبات الموضوعة على النظام البائد، لتستطيع هذه الدولة الناشئة تجاوز العقبات التي تعترض خروجها من هذا المخاض الصعب، لكنها آثرت وضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء”.
ولفت في سياق حديثه إلى أن “القيادة الجديدة ترتكب عديدًا من الأخطاء، مما ينفر الاتحاد الأوروبي من الانفتاح الذي نرجوه ونعوّل عليه، لكن مواجهة هذه الأخطاء لا تتم بوضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء، بل بالحوار المستمر لتلافي الأخطاء المرتكبة، ومن هنا يبقى الأمل أن يدرك قادة الاتحاد الأوروبي وقادة سوريا أيضًا، أن وجود دولة ناجحة على مرمى حجر من حدودهم يعود بالخير علينا وعليهم، ويبقى الأمل في أن تسعى الدول العربية للمبادرة في الانخراط والمساعدة في بناء سوريا دولة وطنية مدنية ناجحة، تقوم بدورها في محيطها العربي والإقليمي والإسلامي والعالمي أيضًا، كون ذلك يشجع باقي الدول للانخراط في دعم الدولة الوليدة، لتجاوز الوضع الصعب الذي ورثته عن النظام الإجرامي البائد”.
يبدو أن تقييم الاتحاد الأوروبي سيكون بوابة أساسية نحو رفع العقوبات عن سوريا، سواء بشكل جزئي أو كامل، ومع أن القرار الأخير بتخفيف بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل يعكس خطوة أولى في هذا الاتجاه، إلا أن الآليات القانونية والسياسية المعقدة تجعل رفع العقوبات مرهونًا بتحقيق مؤشرات إيجابية واضحة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي نهاية شباط/فبراير الماضي تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي طالت لسنوات قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد. وشمل قرار رفع العقوبات مجموعة من القطاعات الرئيسية التي كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية منذ سنوات، وأبرزها: قطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل الذي كان يعاني بشدة من القيود المفروضة عليه.
كما قرر الاتحاد الأوروبي رفع خمس جهات سورية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وتضم هذه الجهات: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، مؤسسة الطيران العربية السورية.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي له، أن هذه الخطوة تهدف إلى “تمكين تلك الجهات من استئناف نشاطاتها الاقتصادية”، كما تم السماح “بوضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بها تحت تصرف البنك المركزي السوري”.
ووفق إبراهيم خولاني، الباحث المساعد في مركز حرمون، فإن رفع العقوبات يتطلب دليلًا واضحًا على تغيّر فعلي في الوضع السياسي والحقوقي، ويُعد التقييم بوابة نحو رفع العقوبات الجزئي أو المشروط، ويشمل مراجعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، مثل إطلاق سراح المعتقلين، وضمان حرية التعبير والتنظيم السياسي، وإذا وجد الاتحاد الأوروبي مؤشرات إيجابية، فقد يتجه إلى رفع جزئي للعقوبات أو تعليق بعضها، مثل تسهيل التحويلات المالية، وتخفيف العقوبات القطاعية، ومنح استثناءات إنسانية موسعة.
علاوة على ذلك، فإن تقييم الاتحاد الأوروبي قد يكون له تأثير غير مباشر على مواقف دول أخرى، خاصةً الخليجية منها، التي تنتظر إشارات من الغرب قبل المضي في مشاريع إعادة الإعمار أو تقديم الدعم المالي، وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي ليس فقط لاعبًا محوريًا في هذا الملف، بل أيضًا مصدر مرجعية للدول الأخرى، حسب خولاني.
طريق طويل مليء بالتحديات
وبينما يفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام علاقة جديدة مع سوريا، فإنه يضع شروطًا صارمة قد تحدد مسار هذه العلاقة، وفي ظل التداخل بين المصالح الأوروبية والأميركية، وبين الحاجة إلى إعادة الإعمار والحذر من الانزلاق نحو ممارسات سابقة، يبدو أن الطريق ما زال طويلًا ومليئًا بالتحديات.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الحكومة السورية الجديدة من تلبية هذه الشروط؟ وهل سيكون هناك توافق أوروبي أميركي على خطوات مستقبلية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد إلى حد كبير ملامح المرحلة المقبلة في الملف السوري.
——————————
إرث نظام الأسد المتجدد.. كيف يتحول نقد السلطة إلى “خيانة”/ أغيد حجازي
20 أبريل 2025
ارتبط نظام الأسد بقمع الحريات واختطاف الأصوات المعارضة عبر آليات التخوين والعنف والسجن والقتل. وبعد سقوطه، كان الأمل معقود على أن تُفتح صفحة جديدة تُعلي صوت النقد البناء. لكن واقعًا مريرًا يطفو اليوم: فئةٌ جديدة تُنعت بـ”الشبيحة الجدد” ترفع شعارات الوطنية، لتحويل أي انتقاد للحكومة أو السلطة إلى “جريمة خيانة”، وكأن الوطن تحول إلى حقل ألغام تُحرم فيه الأسئلة.
النقد السياسي أو المجتمعي لم يكن يومًا ظاهرة مرحبًا بها في أنظمة الحكم الشمولية، لكن التجربة السورية تقدم نموذجًا متقدمًا لتحول النقد من أداة إصلاح إلى جريمة تُقابل بالتشهير والتخوين. ومع تغير بنية السلطة السياسية، لم تنته هذه الظاهرة، بل شهدت أشكالًا جديدة من قبل فئة من المجتمع السوري تتعامل مع الاختلاف في الرأي بوصفه تهديدًا ينبغي سحقه بدلًا من اعتباره ظاهرة صحية تدل على حيوية المجتمع.
استمرارية خطاب التخوين
يُعد التخوين من أبرز أدوات القمع التي استخدمها نظام الأسد، حيث أُقصي كل صوت معارض تحت تهم جاهزة مثل: “مندس”، “عميل”، أو “إرهابي”. لكن المثير للقلق أن هذا الخطاب لم ينته بسقوط النظام، بل تجدد بصيغ مختلفة.
يرى الناشط السوري أدهم تسون أن التحول السياسي لم يغير من جوهر الظاهرة، حيث استمرت أدوات التخوين وأُعيد إنتاجها من قبل فئات جديدة في المجتمع. ويقول: “عندما يتحول النقد البناء إلى “خيانة”، وعندما يُختزل في شتائم واتهامات جاهزة، فهذا ليس مؤشرًا على قوة الموقف الشعبي، بل على أزمة عميقة في الوعي السياسي الذي تُرك ليتشكل تحت وطأة خطاب أحادي لخمسة عقود.
ويتابع: “من الخطأ تفسير ظاهرة التخوين كمجرد انحراف على مواقع التواصل، أو أنها فقط تعبير عن الرأي، بل هي نتاج طبيعي لغياب الوعي السياسي، ولتحول الوطنية إلى طقس شعائري يُختبر بالولاء لا بالمساءلة”. ويقول: “لقد تم تسويق الفكرة لسنوات طويلة بأن الانتقاد يخدم الأعداء، فأصبح لدينا جيلٌ يعتقد أن الدولة صنمٌ يُقدس، لا مؤسسة تخطئ وتُحاسب”.
ويحذر تسون من أن “هذه الظاهرة تُنتج أوطانًا أحادية، فالسوري الذي يسب وينعت منتقدي الحكومة ويصفهم بـ”العملاء” لا يدافع عن سوريا الواقعية بكل مشاكلها، بل عن سوريا المثالية التي تختزل الوطن في السلطة التي تشبهه هو”. ويضيف: “إن هذا الانفصام بين الوطن ككيان مجرد والوطن كمساحة عيش مشترك هو ما يجعل التخوين لدى البعض أسهل من النقاش الواعي”.
ويقول تسون: “نحتاج أولًا إلى مجتمع يتقبل فكرة أن الولاء لا يعني التقديس، فالمعارضة الصحيحة ليست تلك التي تكره الدولة، بل تلك التي تُحبها بما يكفي لترفض أخطاءها وتتحدث عنها. فحين يرفض جزءٌ من المجتمع مجرد سماع انتقاد للحكومة أو مسؤول، فهذا يعني أننا حولنا الوطنية إلى دين طائفي، حيث “الكفر” (أي النقد) يُكفر صاحبه”.
وسائل التواصل الاجتماعي كمسرح للتخوين الرقمي
مع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، انتقل التخوين إلى المجال الرقمي. وهذه المنصات لم تكرس دائمًا الحرية، بل تحولت أحيانًا إلى ساحة لمحاكمات علنية.
يؤكد تسون أن فئة جديدة ظهرت على المنصات الرقمية، تتبنى شعارات الوطنية لتجريم أي انتقاد للحكومة أو للمشهد السياسي الجديد. ويشير إلى أن هذه الفئة باتت تُنصب نفسها حارسة لأبواب الوطنية المزعومة، وتحول أي انتقاد إلى جريمة خيانة، وتستخدم الشتائم والاتهامات الجاهزة لإسكات المخالفين.
في محاولة لرصد نمط الردود المجتمعية على النقد السياسي والاجتماعي، تم تحليل مجموعة من المنشورات النقدية التي تناولت أداء الحكومة، بالإضافة إلى 100 تعليق عشوائي وردت على هذه المنشورات، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. أظهر التحليل أن الخطاب الطائفي والتخويني يظهر بشكل واضح وممنهج في الكثير من الردود، وكانت هذه نتائج التحليل:
1- خطاب تحريضي: رُصدت تعليقات ذات طابع تحريضي، تم فيها اتهام أصحاب الآراء النقدية بأنهم ينتمون إلى طوائف أو جهات معادية، وهو ما يكشف عن محاولات لشيطنة النقد وربطه بانقسامات الهوية لا بمضمونه الفعلي.
2- تكرار وتطابق في الصياغة: عدد كبير من التعليقات حمل مضامين متشابهة، تتضمن اتهامات جاهزة تعني “خائن” و”عميل” و”فلول” دون أي نقاش للأفكار المطروحة. هذا التكرار يثير احتمال وجود حملات منظمة، أو على الأقل نسخ آلي لردود محفوظة يتم تكرارها دون وعي.
3- عدم انسجام مع مضمون المنشورات: الكثير من التعليقات بدت غير منسجمة مع مضمون المنشور الأصلي، ما يعكس نمطًا من التفاعل الذي لا يهدف إلى النقاش بل إلى التشويش أو الترهيب.
يتضح أن وسائل التواصل الاجتماعي، بدلًا من أن تكون وسيلة لتحرير الكلمة، أصبحت في بعض السياقات أداة لإعادة إنتاج القمع بأساليب شعبية وتفاعلية.
تفسير سوسيولوجي لظاهرة التخوين
لمعالجة هذه الظاهرة من منظور علمي، نحتاج إلى فهم البنية الاجتماعية والنفسية التي تنتج هذا النمط من التفكير. فالتخوين ليس فقط خطابًا، بل يعكس أنماطًا معرفية راسخة في المجتمعات.
يشير المختص في علم الاجتماع، منير أحمد، إلى أن التحيز المعرفي هو نمط منهجي في التفكير أو عدم الإدراك يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بسبب المعالجة غير المنطقية وغير الدقيقة للمعلومات، نتيجة قيود العقل البشري في التعامل مع الأفكار الجديدة، وتمسكه بالمعلومات السابقة التي هو متحيز لها.
ويضيف أن “هذا التحيز ناجم عن التشبث بالمعلومات السابقة، فكل مجتمع له سياق فكري ونمط معرفي خاص به، سواء أكان مجتمعًا صغيرًا أو كبيرًا، تُشكل طقوسه وقناعاته التي ترسخت مع الزمن منظومة معرفية يتمسك بها أفراده وتشكل لهم هويتهم الأساسية. لذلك فإن أي طرح جديد يُقابل بالرفض والدفاع عن الأفكار المترسخة، ليس بالضرورة لأنها صحيحة، بل لأنها مألوفة ومتكررة”.
ويتابع أحمد: “هذه الفئات تعتمد على الاستدلال التوافقي المعرفي، فعلى سبيل المثال، المؤيدون بشكل أعمى للنظام السابق كانوا يستدلون على فكرهم من خلال تجارب أنظمة أخرى سقطت وتحولت بلدانها إلى خراب، ويقيسون هذه النتيجة على الواقع السوري، مما يُعزز تحيزهم دون منح أي فرصة للتفكير بفعالية الخيارات البديلة، والضغط المجتمعي يلعب دورًا في انحياز الأفراد لأفكار جماعاتهم، إذ يخشى الكثيرون معارضة السياق العام خشية التهميش أو التنمر، ما يؤدي إلى امتناعهم عن طرح أفكار جديدة”.
يرى أحمد أن هذه الفئةً في المجتمع “تتعامل مع أفكارها باعتبارها جزءًا عضويًا من هويتها، ما يجعل أي طرح جديد يشكل – من وجهة نظرها – تهديدًا وجوديًا لتلك الهُوية يدفعها إلى مهاجمة كل محاولة لتجديد الخطاب الفكري أو مراجعته، عبر رفض قاطع لأية أفكار مغايرة، لا سيما وأن هذه الفئة تُصر على أن الأفكار الجديدة تحتاج إلى “اختبارات واقعية” لإثبات جدارتها، وهي اختباراتٌ تُرفض مسبقًا خوفًا من الفشل، أو هروبًا من مواجهة إمكانية أن تكون الأفكار القديمة غير صالحة”.
ويُرجع أحمد أهم أسباب بروز هذه الفئة إلى عاملين رئيسيين:
1. غياب الوعي المجتمعي بثقافة التغيير وقبول التنوع.
2. نقص التعليم القادر على تعزيز مهارات النقد البناء والحوار.
هذان العاملان – بحسب تحليله – يدفعان الأفراد إلى التكتل في مجموعات مُنغلقة تُحارب الرأي المخالف كآلية دفاع عن “هويتها المهددة”، حتى لو كان هذا الرأي يحمل بذور تطور إيجابي.
حلول مقترحة
ويؤكد منير أحمد أن حل هذه الإشكالية تبدأ عبر:
• بناء جسور الثقة بين أفراد المجتمع، عبر الاعتراف بأهمية الأفكار السائدة واحترامها، دون إلغاء حق الآخرين في طرح البدائل.
• تعزيز ثقافة التعلم عبر ورش عمل وندوات حوارية تشارك فيها جميع الأطياف، لتبني فكرة أن “التغيير ليس عدوانًا على الماضي، بل تطويرٌ لخدمة المستقبل”.
• التدرج في قبول الجديد، لأن الإصرار على التغيير الجذري يُنتج رفضًا عكسيًا، بينما التحول التدريجي يسمح بتهيئة الأفراد نفسيًا وفكريًا.
وينهي بالقول: “الرفض ليس دليلًا على التخلف دائمًا، فقد يكون تعبيرًا عن حاجة إلى مزيد من الشرح أو الوقت. مهمتنا أن نُحول الخوف من التغيير إلى فضول للمعرفة”.
أما أدهم تسون فيختم بالتأكيد على أهمية وجود أصوات حرة تُحب الوطن بما يكفي لتقول له حين يخطئ: “هذا ليس صحيحًا”. “لأن الوطن الحقيقي هو الذي يتسع لأسئلة أبنائه، لا الذي يُجبرهم على الهتاف فقط”.
الترا سوريا
————————–
سوريا اليوم.. يوميات العنف اللغوي في خطاب السلطة الجديدة/ وائل قيس
20 أبريل 2025
في لحظةٍ مفصلية يُعاد فيها رسم ملامح الدولة السورية، تجسّدت أولى صور هذا التحوّل الجذري في سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، بدأت تتشكّل سرديات جديدة ذات طابع شعبوي، تتبناها السلطة الجديدة وأنصارها، وتُستخدم بشكل متزايد بحق من عاشوا في مناطق سيطرة النظام حتى وقت قريب. وبينما كانت التطلعات تتجه نحو بداية مرحلة مدنية ديمقراطية، يجري يوميًا تداول مقاطع مصوّرة في الفضاء الرقمي، تعكس سردية قائمة في المعمعة السورية على الانتقام اللغوي من الآخر منذ سقوط نظام الأسد.
يُغفل أن النسبة الأكبر من السوريين الذين عاشوا في مناطق سيطرة نظام الأسد لـ14 عامًا، نالهم من القمع ما نال غيرهم. لم تكن هناك عائلة لم تُصبها أضرار مباشرة أو غير مباشرة من أفرع النظام الأمنية والعسكرية. ومع ذلك، يطفو على السطح اليوم خطاب سلطوي جديد، يتهم هذه الفئة من السوريين بـ”الصمت” أو “المحاباة”. كما يُنظر إليهم في بعض الأوساط على أنهم فاسدون ضمنًا، تشبّعوا من إرث نظام الأسد، وهو بذلك تناسي لواقع القمع والخوف. هكذا يُراد لإرث المعاناة أن يُمحى، ويُستبدل بصورة نمطية مسبقًا.
أحد أبرز دعائم هذا الخطاب يتمثل في استثمار رمزية القتال الطويل ضد نظام الأسد، الذي خاضته هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة على مدار أكثر من عقد. غير أن هذا الاستثمار تحوّل تدريجيًا إلى أداة لتبرير الإقصاء والتعنيف اللغوي، وذهب إلى إعادة إنتاج القبضة الأمنية بوجه جديد. “اللي بيحرر بقرر”، عبارة طُرحت بكثافة تحذيرات أزمة المناخ العالمية منذ الأيام الأولى لسقوط النظام، وتحوّلت إلى شعار يُرفع في وجه كل من يطالب بمشروع مدني، أو يجرؤ على انتقاد الأداء الإداري أو الأمني للسلطة الجديدة، في مشهد يُعيد التساؤل عن طبيعة “التحرير” ذاته.
وهذا النوع من الخطاب يتغذى على سرديات تُعيد إنتاج نفسها، من خلال عبارات مثل: “وين كنتو الـ14 سنة الماضية؟”، أو “لو كان النظام ما كنتو حكيتو”. وهي تعابير تُحمّل المدنيين مسؤولية صمت مفترض خلال سنوات الحرب، وتُلمّح إلى أن حق التعبير أو النقد يقتصر على من حمل السلاح أو عاش في مناطق المعارضة. في ظل هذا المنطق يُعاد إنتاج ثقافة الإقصاء ذاتها، لكن بأدوات وشعارات جديدة.
لم يعرف التاريخ المعاصر نظامًا أشد وحشية من نظام الأسد الابن. من البراميل المتفجرة إلى المجازر الممنهجة بحق المدنيين، ومن استخدام الأسلحة المحرّمة دوليًا إلى آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، شكّل هذا النظام نموذجًا متطرفًا في القمع والعنف. وتحت أعين الأسد، تحوّلت البلاد إلى شبكة من العشوائيات، ومجتمعات فقيرة منهكة، واقتصاد متهالك. ومع كل هذا، يبرز في المرحلة الجديدة خطاب يتجاهل هذه الخلفية المُثقلة بالألم، معيدًا توزيع الاتهامات على أساس جغرافي.
ويتمثّل الجانب الأخطر في هذا الخطاب بما يرافقه من نزعة تهديدية مباشرة. عبارات من قبيل: “بس لو ما مانعينا نتعرضلكم”، لم تعد مجرّد انفعالات عابرة أو زلات لسان، أو حتى أخطاء فردية، بل أصبحت مؤشر على سردية تكرس عنفًا لغويًا قائم على الانتقام، يحملُ في مضمونه شعورًا دفينًا بالأحقاد، ومرونة مقلقة في تطبيع الإيذاء اللغوي واللفظي معًا. وفي حالات مشابهة تتجاوزها إلى حدود الحريات الشخصية.
ولعل واحدة من تجليات هذه الأحقاد، ما شهدته بعض قرى الساحل السوري من مجازر وعمليات تهجير ونهب استهدفت الطائفة العلوية، في رد انتقامي على سلسلة هجمات شنّتها مجموعات موالية للأسد ضد الأمن العام. هذا التصعيد لم يأتِ من فراغ، بل تغذّى على رواية الانتقام التاريخي، وانفجر في لحظة غياب أي مسار واضح للعدالة أو محاسبة الجناة الحقيقيين.
ما يزيد هذه المخاوف أن بعض هذه الانتهاكات اتخذ طابعًا طائفيًا، مبررًا بانتماء الأسد للطائفة العلوية، وبأن سكان تلك القرى عاشوا في أمان طيلة سنوات الحرب. حتى أولئك الذين لم يخدموا في السلك العسكري، جرى تحميلهم مسؤولية الصمت، باعتباره ذريعة للانتقام. أظهرت الشهادات المصوّرة حجم الفقر المدقع الذي يعيشه سكان ريف الساحل، حيث تعتمد الغالبية على الزراعة كمصدر رزق وحيد، ما يشير إلى أنها نهج قائم على الصورة النمطية.
هذه السرديات تتقاطع بشكل فاضح مع ما وصفه ممدوح عدوان في كتابه الشهير “حيونة الإنسان” حين يُمنح هذا “الإنسان” سلطة مطلقة بلا رقابة. تتكرر جملة من الكتاب على منصات التواصل الاجتماعي، تختصر أصل الحكاية: “إننا نعيش في غابة، والمسافة بين الإنسان والوحش صغيرة لدرجة أن أيًّا منا يمكن أن يكون الضحية أو الجلاد”. صحيح أن الجملة عابرة لكنها مناسبة للحديث عن حالة “الاعتياد”، التي تصب جميع تسمياتها في خانة واحدة: تعويد “الوحش الصغير” على اللجوء إلى العنف اللغوي و/أو اللفظي.
وبالمثل، لا يمكن تجاهل الطابع الشعبوي في هذا الخطاب؛ حيث يتم تبسيط المشهد في ثنائية مُكررة، لكن بمفردات مختلفة: مُحرّر ومخطوف، ثوري وفلول/مكوع. إنها شعبوية مقنّعة تسعى إلى اختزال الظلم على فئة واحدة؛ وفي هذا السياق، تُستخدم اللغة الشعبوية بوصفها أداة هيمنة، وتصبح الكلمات مثل “مُحرر”، “مخطوف”، “فلول” أدوات جاهزة للتصنيف الفوري، حيث تُستبدل بقاموس تعبوي قائم على اصطفاف يتأسس على صورة نمطية مسبقة.
وفي الفضاء الرقمي، تظهر هذه السرديات في حملات التنمر الافتراضي، حيث يُستهدف كل صوت نقدي على وسائل التواصل بحملات تخوين وسخرية وتشويه. هناك من يعتقد أن معركة الحرية انتهت بإسقاط النظام، وأن المطلوب من الجميع هو التصفيق وتبرير الأخطاء. أما من يرفض ذلك، فيُجرد من انتمائه لـ”سوريا الجديدة”، وغيرها من وصفات قاموس اللغة التعبوي.
وفي ظل غياب مسار واضح للعدالة الانتقالية، بمشاركة أممية لضمان الشفافية، تُقدم للمحاكمة الضباط والمسؤولين الكبار في نظام الأسد المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، بالإضافة إلى مرتكبي مجازر الساحل، فإن مخاطر الانزلاق نحو انتقامات عشوائية تزداد. إن تأخير هذه العملية يخلق بيئة فوضوية للعدالة، وهو ما سيؤدي إلى شرخ مجتمعي يهدد السلم الأهلي الهش لدرجة كبيرة، قد يفضي بالبلاد إلى مسارات سوداوية تُفضي في نهاية المطاف إلى الانهيار الكبير.
لقد دفع السوريون ثمنًا باهظًا لإسقاط أحد أعتى الأنظمة وحشية في التاريخ المعاصر، وليس من حق أي فئة أن تصادر هذا الثمن، أو تختزله بأفكار نمطية قائمة على التخوين والنظرة الدونية للآخر/الفرد. تواجه سوريا اليوم، في هذه المرحلة المضطربة من النزاعات الدولية والإقليمية، مصيرًا مجهولًا ومعقّدًا. وفي خضم هذا التحوّل، تتحوّل اللغة إلى أداة انتقامية، مضيفةً إلى أدوات العقاب الجماعي سلاح الكملة.
———————–
==========================
واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 21 نيسان 2025
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع
——————————————
اللامركزية في سوريا.. حل تحمله الثورة أم فخ تفرضه الفوضى؟/ باسل المحمد
2025.04.21
مع دخول سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد، طفت على السطح عشرات الرؤى حول مستقبل الحكم في البلاد، من قبل بعض سلطات الأمر الواقع التي كانت تمارس هذا النوع من الحكم قبل سقوط النظام، مثل “قوات سوريا الديمقراطية” التي تطالب بحكم ذاتي موسّع ضمن إطار لامركزي.
وبينما ترى بعض القوى أن اللامركزية قد تكون مدخلًا لبناء دولة عادلة ومتوازنة، بعد عقود من الحكم المركزي المستبد، يحذر آخرون من أن تطبيق هذا النموذج في ظل الانقسامات الجغرافية والسياسية الحالية قد يعمّق التفتت ويهدد وحدة البلاد.
بالمقابل، تشير العديد من التجارب الإقليمية والدولية إلى أن اللامركزية ليست مجرد خيار إداري، بل مشروع سياسي واجتماعي عميق، يتطلب بيئة مستقرة، وثقافة سياسية ناضجة، وتوافقات وطنية شاملة. فهل سوريا اليوم، بعد كل ما مرّت به، جاهزة لمثل هذا التحول؟ أم أن الحديث عن اللامركزية في ظل هذا التفكك قد يفتح أبوابًا لمزيد من التشظي والانقسام؟
ليست طرحًا جديدًا
لم تكن “اللامركزية” فكرة طارئة على المجتمع السوري بعد سقوط نظام الأسد، فمع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، برزت مجموعة واسعة من المجالس المحلية واللجان المدنية التي أدارت شؤون المدن والقرى في المناطق المحررة، بعيدًا عن مركزية دمشق.
هذه الهياكل، التي بدأت كآليات طوارئ وتنظيم ذاتي لمواجهة الفراغ الأمني والخدمي، تطورت مع مرور السنوات، ونتيجة لظروف سياسية وعسكرية متداخلة، أدت إلى تشكّل أربع سلطات أمر واقع، فرضت نفسها خلال سنوات الحرب، ونجحت إلى حد كبير في إدارة شؤونها المحلية من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
كل من هذه النماذج حمل بصمته الخاصة: ففي شمالي وشرقي سوريا، أسّست “قسد” نظامًا كانتونيًا يعتمد على انتخابات مباشرة ولجان متخصصة لإدارة التعليم والصحة والدفاع الذاتي؛ بينما شهدت إدلب والشمال السوري ولادة حكومتين مصغرتين تُعنيان بالداخلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، مع مجالس محلية منتخبة تعكس تنوع المشهد الثوري؛ وفي السويداء، أثبتت اللجان الشعبية الدرزية قدرتها على تنظيم الأسواق، وتوزيع المواد الإغاثية، وتأمين الحماية الذاتية لأبناء المدينة.
وفي هذا السياق، تشير كثير من الدراسات والتقارير إلى أن هذه النماذج، رغم تفاوتها في التنظيم والتمويل، أثبتت قدرة المجتمع السوري المتنوع على خلق هندسة حكم لا مركزية تحت ضغط الحرب، ما يمهّد اليوم لنقاش جدي حول تحويل هذه “التجارب المؤقتة” إلى مؤسسات دائمة في سوريا ما بعد النظام.
اللامركزية كضرورة
يرى كثير من المطالبين بضرورة تطبيق اللامركزية في سوريا بعد سقوط النظام أن التركيز على نموذج حكم موحّد من دمشق لم يعد يلبّي احتياجات المجتمع السوري وتنوعه، بل قد يزيد خطر تكرار الفراغ الأمني والخدمي الذي انبثق عن النظام المركزي القمعي أيام حكم النظام البائد.
ويستدل الباحثون على ذلك بتجارب الدول التي شهدت تحولات في نظام الحكم، إذ أوضحت أن توزيع السلطات بين المركز والولايات أو المحافظات يساهم في بناء ثقة المواطنين، ويعزز من قدرتهم على المشاركة في صنع القرار، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي على حدّ سواء.
وفي هذا السياق، يرى الباحث الأول في مركز عمران للدراسات، أيمن دسوقي، أن الأنماط الحوكمية المتعددة التي نشأت أيام الثورة، والقائمة على هياكل سلطة وترتيبات مؤسسات مدعّمة باقتصاد سياسي، ما تزال قائمة رغم سقوط نظام الأسد، ولا يمكن أن تتلاشى بسرعة.
وما يدفع باتجاه ضرورة تبنّي نموذج لامركزي، بحسب حديث دسوقي لموقع تلفزيون سوريا، أن مؤسسات الدولة المركزية تعاني من ضعف في القدرات والموارد والإمكانيات، إضافة إلى محدودية في انتشارها الجغرافي، وهو ما يتطلب ترتيبات مجتمعية ومؤسساتية وقانونية واقتصادية لإعادة تنشيطها على كافة الأراضي السورية.
وبالتالي ـ يضيف دسوقي ـ انطلاقًا مما سبق، يمكن القول بضرورة تجاوز النهج المركزي في الحوكمة، لكوارثه الماضية ومحدودية إعادة تأسيسه مجددًا.
إزاء ذلك، نبّه معهد واشنطن للدراسات إلى ضرورة اختيار الفيدرالية كمسار أنسب لإعادة إعمار البلاد، وتجنّب تكرار أخطاء النظام السابق. ورجّح في تقرير أعدّه الأستاذ المشارك مدير الأبحاث في جامعة ليون، فابريس بالونش، أنه “إذا أراد الشرع عدم تكرار أخطاء الأسد، فقد يضطر إلى اللامركزية الحقيقية للسلطة، وإقامة نظام فيدرالي، رغم أن هذا قد يثير أسئلة حول تخصيص الموارد”.
وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد “قسد”، في 10 آذار، والذي نصّ على دمج مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية، إلا أن الإدارة الذاتية ما تزال تؤكد أن “النظام الاتحادي هو المدخل لتسوية سياسية دائمة، يُنهي مركزية القرار، ويمنح المجتمعات المحلية أدوات حقيقية في إدارة شؤونها”، وذلك بحسب تصريحات إلهام أحمد في مؤتمر السليمانية، 17 نيسان الجاري.
مخاطر وتحديات
بمقابل الدعوات التي تطالب بتطبيق اللامركزية باعتبارها حلًا مناسبًا لـ”سوريا الجديدة”، نجد في الطرف المقابل أصواتًا تحذّر من أن اعتماد مبدأ اللامركزية في الحكم، في ظل الظروف التي عاشتها وتعيشها سوريا حاليًا، قد يؤدي إلى صراعات محلية ونزاعات على السلطة، وتفاقم التوترات الطائفية والعرقية القائمة، إضافة إلى احتمال تفكك البلاد وإضعاف الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق، يوضح مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة، أحمد قربي، أن عدم وجود هوية وطنية جامعة يؤمن بها جميع السوريين، بسبب حالات الانقسام الجغرافي والعرقي والطائفي التي سبّبتها الحرب السورية، يُعد من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية في سوريا.
ومن التحديات أيضًا، يتابع قربي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، عدم وجود بُنى قانونية وإدارية قوية تكون مهيأة لتطبيق هذا النموذج في سوريا، التي أُديرت عبر تاريخها بطريقة مركزية شديدة.
ويشرح قربي هذا الجانب بالقول: إنه في ظل عدم وجود جيش قوي، وجهاز أمني متمكّن، وحالة الترهل والضعف في مؤسسات الدولة، فإن تطبيق اللامركزية سيؤدي إلى تفوق الأطراف على المركز، ما يعني الذهاب عمليًا باتجاه التقسيم، كما جرى في العراق على سبيل المثال.
من ناحية أخرى، قد يساهم تطبيق نموذج اللامركزية، من حيث المبدأ، بدعم وتمكين مؤسسات الدولة وليس السلطة، لكن خطورته تكمن في تعدد القوى العسكرية والأمنية على الجغرافيا السورية في الوقت الراهن، والتي من الممكن أن تكون حاملًا محتمَلًا لتنفيذ انقلاب عسكري أو فرض واقع انفصالي في أي وقت، وذلك بحسب الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، عمار فرهود.
وفي الحديث عن تجارب الدول التي نجحت فيها اللامركزية السياسية أو “الفيدرالية”، مثل ألمانيا وسويسرا والهند، يرى مختصون أن تطبيق ذلك في الحالة السورية يواجه عقبات كبيرة، يعود جزء منها إلى التباين الحاد في البنية الديمغرافية وتوزيع الموارد؛ ففي حين تتمتع مناطق شمال شرقي سوريا بثروات طبيعية كبيرة من النفط والزراعة، فإن مناطق أخرى تعاني من هشاشة اقتصادية وافتقار للبنية التحتية، ما يجعل الحديث عن توزيع عادل للسلطة والثروة أمرًا بالغ الحساسية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أعلن معارضته للنظام الاتحادي، خلال مقابلة مع صحيفة “الإيكونوميست” في كانون الثاني الماضي، معتبرًا أنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصبّ في مصلحة سوريا، بحسب تعبيره.
ويُشار إلى أننا هنا لم نتحدث عن العامل الخارجي والإقليمي الذي يعارض هذه الخطوة، وعلى رأسه تركيا، التي تعتبر وجود كيان انفصالي كردي على حدودها الجنوبية تهديدًا لأمنها القومي.
هل من بديل؟
لا يرغب قسم كبير من السوريين بالعودة إلى الحكم المركزي الشديد، الذي عانوا بسببه عقودًا من التهميش والإقصاء في زمن الأسد (الأب والابن). وما زاد في الدفع بهذا الاتجاه هي تجارب الحكم المحلي التي عاشوها خلال سنوات الثورة، والتي أثبتت أنهم قادرون على إدارة مناطقهم رغم الصعوبات والتحديات.
بالمقابل، هناك مخاوف كبيرة لدى القسم الآخر من مخاطر تطبيق اللامركزية في هذا التوقيت، لاعتبارات أمنية متعلقة بوحدة البلاد. لذا، يرى باحثون أن ما تحتاجه سوريا ليس حكمًا مركزيًا شديد التركيز، بل نموذجًا يسمح بالمشاركة الواسعة للمجتمع والمؤسسات المحلية في اتخاذ القرار؛ وهو ما يُعرف بـ”اللامركزية الإدارية”.
وتعليقًا على ما سبق، يقول الباحث فرهود: عندما نضع قواعد الدولة القوية التي تكون فيها السلطة خادمة للشعب، والشعب خادمًا للدولة التي تحمي الجميع، سنصل وقتها إلى قناعة بأن مشاريع الانفصال المستترة بدعاوى اللامركزية، أو مشاريع الدكتاتورية المستترة بضرورة المرحلة، ستسقط أمام الدولة القوية ومؤسساتها المتماسكة؛ لأنها هي الضامن الحقيقي لمكتسبات الثورة ومنجزاتها، وهي الصخرة التي ستتكسر عليها دعاوى تفتيت الدولة أو اختطافها.
أما الباحث أيمن دسوقي، فينوه إلى ضرورة أن تكون المقاربة البديلة ناتجة عن حوار سوري-سوري، وهنا يمكن الاتكاء على الترتيبات الانتقالية التي عقدتها الإدارة السورية الجديدة مع الإدارة الذاتية وبعض المكونات السورية، لما تضمنته، بشكل ما، من إعادة النظر في توزيع الصلاحيات والوظائف، وضمان التمثيل المجتمعي.
ويدعو دسوقي إلى التأسيس لإطار حكم واقعي مرن لإعادة توزيع الصلاحيات والوظائف وتقديم الخدمات بين المركز والأطراف، بحيث يمتلك هذا الإطار قدرة على الحد من عودة الاستبداد مجددًا، عبر معالجة قضايا التمثيل المجتمعي وتوفير ضمانات مؤسساتية.
ولطالما أكدت الإدارة السورية الجديدة على ضرورة إشراك الجميع في العملية السياسية والإدارية، إذ تضمّن الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد “قسد”، على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغضّ النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
كما تضمنت مخرجات الحوار الوطني نصوصًا تؤكد على تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك.
تلفزيون سوريا
——————————————
المقاتلون الأجانب واحتكار السلاح في سورية/ عمار ديوب
20 ابريل 2025
يقتضي الانتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة سياسات وطنية عامّة تقطع مع المرحلة السابقة. يتطلّب النهوض بالدولة إشراك فئات الشعب كافّة وإرضاءها، بغض النظر عن تنويعاتها السياسية والقومية والدينية. وجود مقاتلين أجانب، وفي حالة كارثية في سورية، إلى جانب التنوّع، يستدعي إبعادهم بشكل كامل من شؤون الدولة كلّها، وتحديداً من الجيش والاستخبارات والمناصب السيادية، كما أن حدّة الاستقطاب الطائفي والقومي والضغط الخارجي والحدود مع الدولة الصهيونية يستدعي هذا الإبعاد.
تخلّصت سورية مع زوال نظام الأسد من المقاتلين الأجانب الداعمين له، وهناك ضغط أميركي وتركي، وسوري داخلي، للخلاص من الأجانب الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبالكاد تكتب التقارير الصحافية عن أجانب لدى بقايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتواجه السلطة الحاكمة في سورية نقداً شديداً لوجود المقاتلين الأجانب، ولا سيّما أنّها وضعت بعضهم في مناصب عُليا بالجيش، وأثار الأمر حفيظة السوريين، خاصّة الضبّاط المنشقّين من جيش النظام السابق، فهم من ضحّى بكلّ شيء، والتحق بالثورة، ولا يزالون مُستبعدين من المشاركة في إعادة تأسيس الجيش. كان للمقاتلين الأجانب دور كبير في تصفية فصائل الجيش الحرّ منذ 2012، سواء بتحالفهم مع جبهة النصرة أو “فتح الشام” أو هيئة تحرير الشام أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو “قسد”، وبالطبع، مارس الأجانب ضمن المليشيات الإيرانية أكبر الأدوار في دعم السلطة، وإفشال الثورة. إذاً هناك عدد كبير من المقاتلين الأجانب وفدوا إلى سورية وقاتلوا في مواقع متعدّدة، ويكمن دورهم في تغييب أهداف الثورة وحرف الصراع ليصبح صراعاً طائفياً.
الآن، هناك طلبات داخلية وخارجية للخلاص من الأجانب في ميدان الجيش والدولة، وهي مطالب محقّة، وهي من شروط رفع العقوبات الأميركية والدولية عن سورية، وهناك مطالب كثيرة تتعلّق بإشراك القوى السياسية والاقتصادية والثقافية من خارج مجموعة هيئة تحرير الشام، ومن يدور في فلكها. ورفض إبعاد الأجانب بحجّة قتالهم النظام، وأن هيئة تحرير الشام بذلك تخون المتحالفين معها، وأن هناك مقاتلين أجانب كثيرين اعتُرف بهم في دول كثيرة (كما يقول إعلاميو السلطة)، فيه كثير من عدم فهم واقع سورية الكارثي، والممتدّ بحالة الدمار والإفقار منذ 2011، بل وما قبل 2011، وكذلك فيه تجاهل لدور الأجانب داعمي “الهيئة”، فلقد كانوا ضدّ النظام والفصائل الحرّة معاً، فيُنظَر إليهم أعداءً للثورة السورية، وخطراً كبيراً على إعادة تأسيس الجيش بشكل وطني، وهناك عقائدهم البعيدة من الوطنية السورية، وكان مجيئهم إلى سورية بقصد محاربة “النصيرية” وبناء “دولة الخلافة”، وهناك رفض كامل منهم لأيّ مفرداتٍ تتعلّق بالديمقراطية أو المواطنة أو التعدّدين الديني والقومي. تتعارض رؤى عقائدية كهذه بشكل حاسم مع بناء دولة للسوريين كافّة، والسوريون العلويون جزء منهم بالضرورة. إذاً هناك أسباب كثيرة، وليس طلبات الخارج فقط، تستدعي إبعاد المقاتلين الأجانب.
حاججت كلّ من “قسد” ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بعض الوقت بأن وجود الأجانب في الجيش المُراد تشكيله يُضعف مطالبة السلطة بإبعاد الأجانب الداعمين لـ”قسد”، ولكن الأمر يخصّ أيضاً فصائل السويداء، وحتى الفصائل الداعمة للسلطة ذاتها، فالأغلبية السورية لا تريد مقاتلين أجانبَ في أراضيها. التشكيك بتوجّهات السلطة، وعدم استجابتها لإبعاد هؤلاء الأجانب، ولا سيّما بعد دورهم في مجازر الساحل الطائفية بامتياز، في أوائل الشهر الماضي (مارس/ آذار)، ينتقص من حقّها في احتكار السلاح، إذ ليس من المعقول الموافقة على تسليم السلاح والانتظام في جيشٍ يتشكّل وفيه قيادات أجنبية، أو يتحالف مع جماعات جهادية من أوزبك وشيشان وتركمانستان ومغاربة وسواهم.
أصبحت مسألة إبعاد الأجانب حاسمةً، وتضغط أميركا وأوروبا لإبعادهم بشكل كبير، وهناك تجميد جديد لرفع العقوبات من الاتحاد الأوربي بسبب عدم استجابة سلطة دمشق للشروط الأوروبية، ومنها استبعاد الأجانب، وهناك تقييم سلبي أميركي كبير للسلطة، والاتجاه نحو عدم الاعتراف بها، وبالتالي، هناك أسباب كثيرة تدفع نحو تغيير السلطة توجّهاتها وفكّ العلاقة مع الأجانب العقائديين، وتحويلهم إلى العمل الاقتصادي، وفي حال رفضهم ذلك، فإبعادهم إلى الخارج. وفي الإطار ذاته، لا يجوز السماح لهم بالمشاركة في العمل الدعوي، فالدعويُّ في حالة الأجانب، السلفيين الجهاديين، سيكون متعارضاً مع الوطني، ومع تعزيز الاتجاهات الإسلامية الوطنية.
تتجه السلطة في دمشق إلى تشريع نفسها عبر العلاقة مع الخارج، وإذ بدأت بالشعور بثقل المطالب الأميركية والأوروبية راحت تتجه نحو تركيا والخليج للمساهمة في التخفيف من ذلك الثقل، وجولة الرئيس أحمد الشرع الإقليمية، أخيراً، تأتي في هذا الاتجاه، وبهدف تأمين الدعم وتشريع سلطته، وإن نال بعض الدعمين المادي والسياسي، فإن الشروط الدولية ستظلُّ الأساس في العلاقة مع دمشق. تتعزّز قوّة السلطة تجاه الشروط الدولية عبر الحقوق التي يتمتع بها الشعب، فهل ستعي السلطة أن الشعب هو مصدر الشرعية والقوّة؟
تعيد السلطة الحالية سياسات النظام القديم، الذي أدار ظهره للشعب وتحالف مع إيران ومليشياتها وروسيا، وكانت الحصيلة انهيار حكمه، الذي أُجِّل منذ 2012 إلى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024. وسورية لا تحتمل تكرار السياسات نفسها، وهي في حالة كارثية، وفي المستويات كافّة، وتتطلّب سياسات وطنية في الاقتصاد والتعليم والثقافة والجيش وإدارة مؤسّسات الدولة، وإشراك الفعّاليات السياسية والثقافية وسواها، المستقلة عن السلطة. هنا مصدر الشرعية، ومن هنا الرفض الواسع لتنصيب المقاتلين الأجانب بقيادة الجيش أو جعلهم فصيلاً فيه. ينتهك هذا وطنية السوريين، ويؤسّس جيشاً غير وطني.
تخطئ السلطة في محاولة تشريع نفسها عبر الخارج، فللخارج مصالحه، وهناك أشكال من التعارض بين مصالح الخارج ومصالح الداخل، ويتقلّص التعارض بمقدار الانطلاق من مصالح الداخل، إذ ستكون مصالح الداخل الأساس في أيّ مفاوضات بخصوص النهوض بسورية، وفي غياب الشرعية الداخلية ومصادر القوة الداخلية، ستتعرّض السلطة لضغوط كبيرة، وستنتقل لاحقاً لتصبح أداةً بيد الخارج، وربّما تنهار سريعاً.
قوة السلطة الحالية متأتية من إسقاط النظام التابع وتخليص سورية من النفوذين الإيراني والروسي، ومن شعور الشعب بأن ثورته انتصرت أخيراً. سيتغيّر هذا التفكير كلّه باستمرار إدارة الظهر للشعب. ومسألة المقاتلين الأجانب قضية حساسة في سورية، وستكون قابلة للانفجار في أيّ لحظة، سواء بسبب رؤية هؤلاء الأجانب السلفية المتعارضة مع التديّن السوري السائد، أو رغبتهم في تقييد توجّهات السلطة “الوطنية” الجديدة، أو من خلال الضغوط الخارجية والاستمرار في العقوبات، وهناك الدولة الصهيونية التي تنتقد سلطة دمشق، وتقدّمت باتجاه ثلاث محافظات، بسبب “مخاطر السلفية الجهادية”، كما تدّعي.
سيكون الإصرار على عدم إبعاد المقاتلين الأجانب سبباً في تراجع الدعم الإقليمي والدولي، والمصدر الأساس لشرعية السلطة هو الاستجابة لمصالح الشعب وحقوقه والمسارعة بإبعادهم، ومن دون ذلك ستظلُّ الشرعية منقوصة، وهناك إمكانية لأشكال التدخّل الخارجي، وعكس ذلك حينما تتبنّى السلطة مشروعاً وطنياً وديموقراطياً ويتمظهر في شؤون الدولة كلّها.
العربي الجديد
——————————————
==========================
عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 21 نيسان 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
——————————————
سوريا ميدان النفوذ.. انكفاء واشنطن وتمدد أنقرة وقلق تل أبيب/ عبد الله مكسور
2025.04.21
“الفراغ في السياسة كما في الطبيعة، لا يلبث أن يُملأ، وغالبًا ما تملأه القوى الأكثر استعدادًا لا الأكثر شرعية.”، أتذكر هذا القول لنيكولا ميكافيللي وأمامي ترتسم الجغرافيا السورية بحدود سايكس بيكو الاستعمارية التي نعرفها، وفيها وعليها ترنُّ صدى الخُطى المتسارعة للقوى الإقليمية والدولية، لتتشكّل خارطة جديدة، تُرسم لا بالحدود بل بالقواعد العسكرية، ولا بالحكومات بل بمراكز السيطرة. سوريا التي مرَّت بسنوات عجاف تحت حكم نظام الأسد، تحوّلت بعد 8 ديسمبر 2024 إلى قلب معركة النفوذ- بشكل أو بآخر- بين تركيا وإسرائيل، في ظل انكفاء أميركي متدرّج، وغياب سوري موجع عن طاولة القرار.
سوريا اليوم في ظرفها الحالي ليست “دولة” بالمعنى التقليدي، بل ميدان، لا تُدار فيه النزاعات فحسب، بل تُختبر فيه الرؤى الكبرى لإعادة توزيع السلطة في الشرق الأوسط. واللافت أن الانسحاب الأميركي المرتقب ليس مجرد خطوة عسكرية، بل إعلان ضمني بانتهاء مرحلة وبدء أخرى، قوامها التفاهم التركي–الإسرائيلي الخفي، والمراهنة الروسية الباردة، ومحاولات سورية محلية لبناء دولة من ركام النظام القديم وعلى أنقاضه.
منذ سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر 2024، بدأت توازنات ما بعد الحرب تنقلب على رأسها وتظهر بشكل أكثر وضوحا. القوى التي ظلت لعقد كامل—تراقب، تُفاوض، تُناور—وجدت نفسها فجأة أمام فرصة تاريخية لتوسيع نفوذها وفرض رؤيتها للمنطقة. تركيا، التي لطالما نظرت إلى الشمال السوري باعتباره عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي، اندفعت بثقة نحو ما بعد خطوط الفصل، مستندةً إلى تفويض سياسي غير معلن جرى في كواليس باكو بين أنقرة وتل أبيب، وتحت رعاية موسكو غير المعلنة وغير الحاضرة رسمياً في أذربيجان.
في المقابل، لم تُخفِ إسرائيل قلقها، لكنها لم تواجهه بالصوت، بل بالتفاهم. فمع وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مجددًا، عاد منطق “الصفقات الكبرى” ليحكم السياسة الخارجية الأميركية، لا منطق “الالتزام طويل الأمد”. ترمب، الذي لا يرى في سوريا إلا ساحة عبء، اختار أن يُفرغها من الجنود لا من النفوذ، وأن يُسلّم أوراقها لحلفاء موثوقين، قادرين على إدارة مصالح واشنطن بأدوات إقليمية. وهكذا، وُلدت تفاهمات أذربيجان، بحسب ما تسرّب منها، مساحة عازلة لأنقرة، ومجال مراقبة آمن لتل أبيب، في مقابل انسحاب تكتيكي أميركي يُبقي اليد على الزناد حتى من دون أن يظهر.
لكن هذه الترتيبات لا تلغي الحقيقة المرّة: أن سوريا باتت اليوم مسرحًا لفائض القوة التركية، وهاجسًا أمنيًا دائمًا لتل أبيب، وحقل اختبار لمدى قدرة الروس على ملء الفراغ الأميركي من دون التورط في مستنقع جديد. فأنقرة تتحرك بثقة القوة الناعمة والصلبة معًا، من التعليم إلى الإدارة المحلية، ومن النفوذ العسكري إلى الشبكات الاقتصادية، في حين إسرائيل تراقب وتتدخل حين يلزم وفقا لمنطق اللزوم لديها، وتعيد تموضعها البري والجوي والاستخباراتي بما يتناسب مع ديناميكيات مرحلة ما بعد الأسد.
أما واشنطن، فرغم انسحابها المعلن، لا تزال تمسك بالخيوط الطويلة: تدفقات السلاح، نظم الرقابة الجوية، المنصات النفطية، وقنوات القرار الكردي. فهي تُغادر ولكن لا ترحل، وتسمح للآخرين بلعب الدور، لكنها تبقى المرجع الأعلى لمعادلات الأمن. هكذا، يتشكّل ميدان جديد في سوريا، ميدان بلا سيادة، بلا مركز، حيث تتزاحم الوصايات وتتماهى التحالفات. مشهدٌ يشبه رقعة شطرنج، لكنّ اللاعبين ليسوا متقابلين، بل متداخلين، وكلٌ منهم يمسك قطعةً من اللعبة، يحرّكها وفق منطقٍ لا يُقال أو يُعلَن، بل يُفهم من خريطة النفوذ. وكأننا ضمن مشهد في رواية “لاعب الشطرنج” لستيفان زفايغ على متن سفينة تمخر البحر في أميركا اللاتينية.
واشنطن تُغادر… لكنها لا ترحل
في الأدبيات العسكرية الأميركية تتردد الجملة التالية بشكل غير معلن: “الانسحاب لا يعني الرحيل، بل إعادة التموضع خلف الستار.”، فالحديث عن انسحاب أميركي من سوريا في أي مرحلة زمنية لم يكن يومًا حديث نهاية، بل إعلان عن تحول في نمط السيطرة. فواشنطن، التي دخلت الأراضي السورية في خريف 2014 تحت لافتة “التحالف الدولي لمحاربة داعش”، لم تكن تسعى إلى احتلال أرض، بل إلى احتلال قرار. والفرق بين الإثنين جوهري: فالأرض يمكن مغادرتها، أما القرار فالبقاء فيه يتخذ أشكالًا أكثر نعومةً وتأثيرًا. وعند التدقيق في طبيعة التمركز الأميركي في سوريا خلال العقد الأخير – رغم شح المعلومات عن عدد وحقيقة القواعد الأميركية في الأراضي السورية-، يتضح أنه كان أقرب إلى “الاحتلال الذكي” منه إلى الاحتلال التقليدي. ففي الشمال الشرقي، من رميلان إلى الحسكة، ومن الشدادي إلى التنف، أقامت الولايات المتحدة منظومة من القواعد العسكرية التي لا تتمدد أفقيًا بل عموديًا: تحت الأرض وفي السماء، ضمن قواعد قواعد اشتباك دقيقة، مفصّلة، ومتغيرة بحسب اللحظة السياسية والإقليمية. وبخلاف الرواية الرسمية التي أُطلقت عام 2014، بتركيز على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، فإن القواعد الأميركية في سوريا أُقيمت لأسباب استراتيجية تتجاوز ذلك التهديد العابر. فقد أدركت واشنطن منذ سنوات الفوضى الأولى أن سوريا ليست مجرد ساحة حرب، بل معبر ومفترق وملتقى. هي نقطة التقاء بين خطوط إمداد إيران إلى حزب الله، وبين الحدود الحساسة لإسرائيل، وبين الجغرافيا العميقة التي تمتد إلى الأنبار العراقية ومايليها حيث يتعاظم النفوذ الإيراني منذ عام 2003.
لهذا، كانت قاعدة “التنف” نموذجًا صارخًا لجوهر العقيدة العسكرية الأميركية الجديدة: قواعد صغيرة، مرنة، بلا مظاهر كبيرة، لكن ذات فعالية استخباراتية عالية، ومتموضعة على نقاط الخطر. التنف، الواقعة على مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، لم تكن قاعدة لمحاربة تنظيم الدولة فقط، بل لمراقبة التحركات الإيرانية بدقة، ولمنع الربط البري بين طهران وبيروت. كانت عين واشنطن على طريق الحرير الإيراني الجديد، وليس فقط على مقاتلي التنظيم المهزوم. وقد ساقتني الأقدار إلى لقاء مع ضابط خدم في التنف وقد أسرَّ لي عن استخدام القاعدة في مرحلة ما كسجن مؤقت لعناصر من تنظيم داعش قبل نقلهم إلى وجهات غير معلومة.
قواعد الاشتباك: جيوش تحت الوصاية
منذ اللحظة الأولى، لم تكتفِ واشنطن بتثبيت مواقع عسكرية، بل أسّست لشكل غير معلن من قواعد الاشتباك بين جميع القوى الفاعلة في الميدان السوري. فعبر دعمها لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، تمكنت من خلق جيش محلي بالوكالة، تديره بأدوات التمويل والتدريب، وتتحكم عبره بمساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا، وهذا ليس خافياً على أحد. لكن الدعم الأميركي لم يكن مطلقًا. بل جاء مشروطًا بخضوع هذا “الجيش الوكيل” لشبكة من التعليمات، تبدأ بحدود التحرك، ولا تنتهي بقوائم الأهداف. كانت قسد تعرف أن إطلاق رصاصة واحدة خارج التنسيق مع الأميركيين قد يُفقدها الدعم، وأن التحرك تجاه الحدود التركية أو الاقتراب من مناطق جيش نظام الأسد قد يُدخلها في عاصفة مع واشنطن.
ولعل أخطر ما كرّسته هذه العلاقة هو تعويم مفهوم “السيادة المنقوصة” في مناطق قسد، حيث بات القرار المحلي مشروطًا بإرادة القاعدة العسكرية القريبة، وتحديدًا تلك المنتشرة في رميلان والمالكية وشرقي دير الزور. وضمن منطق ضبط إيقاع الحرب والسلام لم تكن القواعد الأميركية معزولة، بل نسجت شبكة من العلاقات النشطة، إن لم نقل المُهيمنة، مع الفاعلين الإقليميين. مع تركيا، حافظت واشنطن على توازن هش، من خلال إرسال تطمينات استخباراتية، ومحاولة ضبط اندفاعات أنقرة نحو العمق السوري.
في حين أخذت هذه القواعد مع إسرائيل، شكلاً آخر فقد كانت ركيزة لتبادل المعلومات في إطار ما يمكن أن يتم تعريفه بـ”الاحتواء الذكي لإيران”. إذ لطالما مثّلت القواعد الأميركية في شرقي سوريا نقاط إنذار مبكر لأي تحرك إيراني قد يستهدف الجولان أو غيره، وهو ما اعتمدت عليه تل أبيب في كثير من عملياتها الجوية التي نفّذتها داخل سوريا خلال العقد الأخير.
أما مع روسيا، فكانت العلاقة أكثر تعقيدًا. فرغم العداء الظاهر، جرت تفاهمات تحت الطاولة يمكن تلمُّسها من اتفاق “عدم التصادم الجوي”، الذي قنن حركة الطائرات في سماء سوريا، وفصل مناطق السيطرة الأميركية عن تلك الروسية. هذه التفاهمات أوجدت نوعًا من “الهدنة الدائمة” بين القوتين، لكنها في الوقت نفسه ثبّتت حالة الانقسام الجغرافي لسوريا.
السؤال الجوهري الآن لماذا تُعلن واشنطن اليوم نيتها الرحيل؟ وهل هو فعلاً انسحاب، أم إعادة توزيع للقوة؟ المتابع يدرك أن الانسحاب لا يأتي من فراغ، بل من قراءة أميركية لتغير قواعد اللعبة. فسقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 أنهى توازنًا هشًا استمر لأكثر من عقد، وفتح الباب أمام فاعلين جدد – لا سيما تركيا – لملء الفراغ. كما أن تراجع التهديد الإيراني المباشر في الشرق قلّص مبررات البقاء العسكري الأميركي. إلى ذلك، هناك بُعد داخلي أميركي لا يُستهان به، وهذا يتمثل بالشارع الأميركي الذي لم يعد يتحمل وجود قواته في مناطق بلا أفق سياسي واضح، والنخبة السياسية التي ترى في الانسحاب “استثمارًا مقلوبًا” يقوم على الإنفاق المتزايد مقابل المكاسب السياسية المحدودة.
لكن هل ترحل واشنطن فعلاً؟ هنا يكمن جوهر المعادلة. الولايات المتحدة قد تسحب جنودها، لكنها لن تسحب نفوذها. فالمعسكرات التي تركتها وراءها درّبت أجيالًا من القادة المحليين، وغرست ثقافة القرار المؤسسي وفق الرؤية الأميركية. كما أن البنى الاستخباراتية التي بُنيت خلال السنوات العشر الماضية قادرة على البقاء من دون علم ظاهر. لقد أتقنت واشنطن وفق ما تعلمناه عنها لعبة “الوجود الغائب”: لا قواعد كبرى، لا أعلام، لا بيانات نارية، بل أدوات تحكم عن بُعد. كما لو أنها تُعيد إنتاج استعمار القرن الحادي والعشرين بنسخته الناعمة: تقنيات، شبكات، وكلاء… من دون الحاجة لدبابات أو جندي تقليدي يقف في الشارع. وفي ظل هذا النمط الجديد، قد يكون انسحاب واشنطن من سوريا أكبر دليل على استمرارها فيها. ذلك أن القوة الحقيقية، كما قال ميشال فوكو، لا تُقاس بوجود السلاح، بل بقدرة من يملك السلاح على فرض صمته في اللحظة المناسبة.
تركيا: من بوابة الحدود إلى قلب البادية
دخلت تركيا إلى شمالي سوريا تحت شعار مكافحة الإرهاب. لكن اليوم، بعد ديسمبر 2024، دخلت إلى قلب البلاد، من تدمر إلى البادية إلى مطار حماة، تحت شعار “إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية”. هذه ليست عملية أمنية بالمعنى التقليدي، بل مشروع نفوذ، يمكن مقاربته مع ما فعله العثمانيون في نهاية القرن التاسع عشر حين أنشأوا “قائمقاميات أمنية” في أطراف المشرق لضمان السيطرة على المركزـ مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات والمعاني والدلالات. فما يتم الحديث عنه اليوم بأن تركيا لا تبني مجرد قواعد عسكرية، بل بنية تحتية لنفوذ يبدو أنه طويل الأمد: نقاط مراقبة تحوّلت إلى معسكرات، ومعسكرات باتت تضم مراكز تدريب، ومراكز التدريب أصبحت مختبرًا يسهم بشكل أو بآخر بآليات إنتاج جيش سوري جديد، هذه القواعد لا تقوم على حدود الاشتباك بل على فلسفة التموضع، فكل قاعدة يتم الإشارة للتحضير لها في تدمر أو في محيط السخنة أو شرقي حماة ليست موضع تمركز عسكري فحسب، بل نقطة تَمثّل سياسي وتَوسّع مؤسسي، من خلالها تُصدّر أنقرة نسختها من الدولة “المنضبطة” التي تريد في سوريا، بما تحمله من مركزية وشبكات خدمات. وهكذا يجب فهمها والتعامل معها.
يمكن التوقف هنا عند تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال منتدى أنطاليا في فبراير 2025، والتي كانت أشبه ببيان تأسيسي لمرحلة جديدة. حيث قال: “تركيا ليست قوة احتلال، بل قوة استقرار. نحن لا ندخل الفراغ، بل نملؤه بأدوات البناء”، وهو بذلك لا يعبّر عن تحوّل في خطاب أنقرة فقط، بل عن نقلة في العقيدة التركية نفسها تجاه سوريا، عقيدة جديدة تنتقل من الحماية إلى الشراكة، ومن الأمن إلى الإدارة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزّز هذا التوجّه في خطابٍ وُصف بأنه “تاريخي”، حين قال: “نقف إلى جانب سوريا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وسنُسهم في إعادة بناء مؤسساتها بما يخدم وحدة ترابها وكرامة شعبها.” لكن ما لم يُقال، وما يُفهم بين السطور، هو أن “سوريا” هنا لم تعد الدولة بل المساحة، ولم تعد العلاقة التي تحكمها أخوّة الجغرافيا ومنطق المهاجرين والأنصار بل ضرورات التمركز الاستراتيجي الذي دفع أردوغان للقول بأن من يسعى إلى تقسيم سوريا عليه أن يواجه تركيا ذاتها.
في العمق من كل هذا، تسعى تركيا إلى صياغة واقع جديد على الأرض، يتجاوز فكرة “المنطقة الآمنة” التقليدية إلى “المجال الآمن الموسّع” الذي يمتد من اعزاز والباب بريف حلب، إلى الرقة ودير الزور، وصولًا إلى تدمر وخطوط البادية. ففي المحصلة لا تخفي تركيا أنها تتطلع لأن تكون القوة المرجعية في “سوريا الجديدة”، مستندةً إلى مقاربة هجينة تجمع بين القوّة الخشنة والناعمة، وبين السيادة المفككة والشرعية المتفاوض عليها. هي تُنشئ قواعد، لكنها تتحدّث عن المدارس، وتُسيّر أرتالًا عسكرية نشاهد صورها لكنها تدشّن شبكات مياه وكهرباء، وتبني ما تصفه بـ”العمق الاستراتيجي الاجتماعي”، كما ورد في أحد تقارير مراكز الدراسات الأمنية التركية. وهكذا، تمضي تركيا في مشروعها: لا كمجرّد لاعب عسكري، بل كفاعل سياسي يعمل على إعادة صياغة المركز من الأطراف، وفرض إيقاع تركي في قلب بلاد الشام، بحجّة إعادة البناء، وبهدف إعادة التموضع. والمفارقة أن هذا “التموضع” لا يصطدم فقط بإسرائيل أو بواشنطن، بل حتى بما تبقّى من “الدولة السورية” ذاتها في المستقبل القريب.
إسرائيل.. الخوف من حليف الأمس
إسرائيل التي كانت تُجاهر علنًا بعدائها لإيران، بدأت تهمس بقلقها من تركيا. القواعد التركية المزمع إقامتها في حماة وتدمر تمثّل، وفق المعنى الذي تسرَّب عن وصف جنرال إسرائيلي في محادثات باكو، “خطرًا غير مباشر لكنه أكثر ذكاءً”. فتركيا تبني جيشًا سوريًا لا يمكن التنبؤ بمآلاته، وتزرع أعينًا إلكترونية – من الرادارات والطائرات المسيّرة – على بُعد لا يتجاوز 500 كم من الجولان المحتل. فالقلق الإسرائيلي من أنقرة لا يتأتى هنا فقط من هذه الزاوية، بل من كفاءة هذا الوجود. فتل أبيب ترى في أنقرة منافسًا أمنيًا من نوع جديد “منافس لا يُشهر سلاحه، لكنه ينسج خرائط الولاء بهدوء”. وما التفاهمات التي جرت في أذربيجان سوى محاولة لتقنين هذا القلق، عبر إقامة “آلية تفادي الصِدام”، شبيهة بتلك التي أُبرمت مع الروس عام 2015.
في تقديري أن إسرائيل تشعر بوجود تركيا أنها أمام قوة ذات طابع إمبراطوري ناعم تستند إلى العاطفة، هذه القوة لا تسعى إلى الاجتياح بل لإعادة تدوير الهويات. وهذا يُشكّل خطرًا بنيويًا على فلسفة الردع الإسرائيلي التي بُنيت منذ حرب أكتوبر 1973 على فكرة: “السيطرة من الجو، والتفتيت على الأرض. ووفق قراءات استراتيجية فإن” تركيا تُقوّض هذه المعادلة من خلال السعي إلى توحيد الأرض السورية جزئيًا، تحت مظلة مرجعية تركية سواء كانت حاضرة أم غير حاضرة، تحاكي تجربة الباكستان مع أفغانستان في الثمانينيات، أو إيران مع “محور المقاومة” خلال العقدين الماضيين.
ثمّة قلق أعمق يراود المؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل، وهو أن الحليف الأميركي الذي كان يتولى “تنظيم المسرح السوري” لصالح تل أبيب، قد تراجع إلى خلف الستار، مفسحًا المجال أمام لاعبين أكثر مرونة، وأكثر شراسة على المدى الطويل. هنا، يظهر “التهديد التركي” ليس في القوة النارية، بل في القدرة على البناء المتراكم، في الزمن. إسرائيل تجيد الاشتباك مع عدو واضح، وتَربكها خصومة بطيئة تتقدّم بالطبقات والمساحة الاجتماعية لا بالصواريخ. والأخطر من كل ذلك، هو أن تركيا لا تُرسل رسائل مباشرة، بل تعمل بصمت، وتراهن على أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون محكومًا بالعجز الاستراتيجي وضبط الولايات المتحدة، فإسرائيل لا تستطيع ضرب أو استهداف قواعد تركية معلنة في تدمر أو غيرها من دون المجازفة بتفجير العلاقة مع الناتو، ولا تقدر على منع إنشاء شبكات النفوذ التركية داخل سوريا، لأن هذه الشبكات لا تُبنى بالدبابات، بل بالمنظمات غير الحكومية، والمناهج، والتدريب، والمياه، وربما بالرعاية الأوروبية والأميركية نفسها. لهذا يفكِّر العقل الإسرائيلي دائماً بوصف التمدد التركي بأنه الخصم الذي لا يحمل لافتة. وهو توصيف دقيق يعكس مأزقًا فكريًا يحمل التناقض في الطرح داخل العقل الإسرائيلي، فهل أنقرة حليف في الإقليم ضد طهران؟ أم منافس سري على النفوذ في سوريا؟ وهل يمكن الوثوق بمن يمدّ لك اليد في البحر المتوسط ويرمي عينه على البادية السورية؟
أمام هذه الأرضية يأتي الانكفاء الأميركي بعد ديسمبر 2024، وعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهذا ما زاد من اضطراب البوصلة الإسرائيلية. فالإدارة الجديدة في واشنطن أكثر انشغالًا بالصين والرسوم الجمركية وحدود المكسيك واللاجئين وبإعادة ترتيب البيت الداخلي، وأقلّ حماسًا لاستمرار دعم الخرائط الأمنية في المشرق. ترمب، براغماتيًا، لا يرى في الوجود التركي خطرًا، ظهر هذا جلياً فيما تسرَّب عن المحادثة الهاتفية بين ترمب أردوغان، ترمب يقول لأردوغان لقد أخذت سوريا، لقد فعلتها، وبهذا المنطق الترمبي يجد الأميركي غطاءً وفرصة لتقليص كلفة التورط الأميركي. لكن تل أبيب لا تشارك البيت الأبيض هذا الاطمئنان، هي لا تقرأ التحالفات بمصطلحات الميزانيات المالية وفق حسابات ترمب، بل بمفردات الوجود والنفوذ والذاكرة التاريخية والسردية الصهيونية.
ولهذا، بدأت إسرائيل تتحرّك على مستويات جديدة: تعزيز التنسيق الأمني مع اليونان وقبرص، فتح خطوط تواصل غير معلنة مع بعض المناطق في جنوبي سوريا، وتكثيف مراقبة البادية بالأقمار الاصطناعية، وحتى وصل بها الحال إلى تقديم مقترحات لنشر “قوات رمزية” أممية في بعض مناطق التماس مع إعلانها انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974. كل ذلك في محاولة لتثبيت وزنها في معادلة تزداد تسيّبًا، وتبتعد أكثر فأكثر عن الترسيم القديم لما يُسمّى بـ”سوريا المفيدة لإسرائيل”.، فتل أبيب تخاف من أن تستيقظ ذات يوم، وتجد أن سوريا لم تَعُد ساحة فوضى بل ساحة نفوذ مركّز، تُديرها أنقرة بهدوء، وتُراقبها موسكو ببرود، وتنسحب منها واشنطن بصمت.
باكو: منصة التفاهمات الجديدة
في مكان يمكن وصفه بالساحة غير الرسمية للتفاهمات المعقدة، جلس مسؤولون أتراك وإسرائيليون في أذربيجان، وهذا اللقاء ليس مجرد حدث عابر في منطق الأحداث في سوريا، فما تسرَّب عن محادثات أو مفاوضات أو اجتماع باكو يعني رسم خرائط جديدة للنفوذ، حيث تتقاطع مصالح الدول التي قد تظهر علنًا على خلاف، ولكنها تتفق في الخفاء على خطوط الاشتباك، والحديث هنا عن الطيران ومسارات الدوريات، ونقاط التحرك التي تبقى غير معلنة. هذه ليست مجرد محادثات دبلوماسية تقليدية، بل محاولات لتشكيل معادلات جديدة للأمن والنفوذ في المنطقة. الآلية التي سُمّيت بـ “تفادي التصادم” لم تكن في جوهرها سوى مقدمة لتفاهمات أعمق بكثير، تتجاوز الإطار الظاهر لتدخل في مفاوضات غير مرئية حول “من يسيطر على ماذا”، وما هي التنازلات التي يتم قبولها في إطار لعبة السلطة الإقليمية. وكما غابت سوريا عن الاجتماعات المتعلقة بمستقبلها في أنطاليا غابت عن اجتماع باكو، حتى لم يصدر من الدولة السورية الجديدة أي موقف مهما كان مستواه تجاه اللقاء والتفاهمات. لقد غابت دمشق عن الطاولة، رغم أن مصيرها هو المعني الأول بهذه التوافقات. تحضرني الآن تلك اللحظة التي نوقشت فيها جغرافيا الشرق الأوسط وتحولت إلى خرائط في بداية القرن العشرين، كنا غائبين والغياب فرض أن يرسم الحاضر ما يتصل بنا وبمستقبلنا الذي نعيش اليوم.
روسيا أيضاً غابت عن باكو، لكن حضورها في سوريا يبدو اليوم مثل “ظل” إمبراطورية كانت ذات يوم صاحبة اليد الطولى. موسكو تراقب بقلق بالغ كل قاعدة تركية جديدة تُبنى على الأرض السورية، لكنها تجد نفسها في موقف يمكن وضعه في خانة “العجز” أمام ضغوط أكبر تتعرض لها على جبهات أخرى، خاصة في أوكرانيا والعلاقة المعقدة مع حلف شمال الأطلسي. روسيا تدرك تمامًا أن أنقرة تتوسع في مناطق كانت حتى وقت قريب في دائرة النفوذ الروسي، ولكنها في الوقت نفسه لا تملك القدرة على ردعها بشكل حاسم في هذه المرحلة. ومع ذلك، تحافظ موسكو على “حق الاعتراض”.
في تصريحات له من أنطاليا، قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي: “نتشارك مع الروس الرؤية الأمنية في سوريا”. وهذه العبارة تبيّن أن التعاون بين أنقرة وموسكو ليس تحالفًا استراتيجيًا بالمعنى التقليدي، بل هو تحالف مصلحي يهدف إلى الحفاظ على حد أدنى من التوازن في المنطقة. روسيا قد لا تتدخل بشكل مباشر في المواجهات التركية-الإسرائيلية – فيما لو حدثت- على الأرض السورية، ولكنها تظل حاضرة بشكل غير مرئي، تراقب عن كثب كل تحرك قد يهدد مصالحها في المدى الطويل، وربما اختيار باكو لمسرح الظل في اللقاء الإسرائيلي التركي لم يكن بعيداً عن المظلة الروسية الحاضرة الغائبة لما تربط موسكو مع باكو من روابط.
سوريا: الغائب الحاضر
في قلب المعادلة السورية المعقدة اليوم، يغيب السؤال المركزي الذي كان يجب أن يكون في صدارة اهتمامات الجميع: ماذا عن سوريا نفسها؟ من يُمثّلها؟ من هو القادر على التفاوض باسمها؟ من يملك سلطة رسم حدودها، سياسياً وعسكرياً، سواء على الأرض أو في أروقة القوى الكبرى التي تتنازع النفوذ فيها؟
مع انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، واجهت سوريا – وما تزال- تحديات هائلة في تحديد هويتها السياسية الجديدة. الإدارة السورية الجديدة، التي تكونت بعد سقوط النظام، كانت في البداية مجرد حالة انتقالية تطرح رؤى مختلفة ومتناقضة تجاه القدرة على بناء مؤسسات قوية قادرة على إعادة استقرار الدولة. ورغم ذلك، فإن هذه الإدارة تعمل على تجاوز العثرات، إذ تجري – وفق ما يتسرب- تفاهمات خفية مع أنقرة، وتراهن على الدعم الروسي، وتخطو ببطء نحو إعادة بناء الجيش الوطني السوري بعيداً عن عقيدة جيش الأسد الذي تحول إلى مجرد جماعات متمردة وشظايا من بقايا السلطة أو ما اصطلح عليه سوريا ” الفلول”. حتى سياسياً تحاول الإدارة الجديدة أن تمثّل حالة القطيعة مع مسار نظام الأسد، وهذا يظهر جلياً في إصرارها السياسي وإلحاحها على أنها دولة سلام تريد صفر مشكلات مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل التي تحتل الجولان وتنفّذ توغّلات عسكرية وتوسِّع منطقتها العازلة، وتقصف في وضح النهار وظلام الليل ما تبقى من ترسانة عسكرية تتبع للدولة السورية، والصادم – وفق قراءات مختلفة- أن بيانات وزارة الخارجية السورية خرجت عن كل الثوابت السورية حين لم تصف إسرائيل بالاحتلال أو العدو أو الكيان وفق الأدبيات السورية منذ النكبة الفلسطينية.
وبالرغم من كل ما سبق إذا كانت الإدارة السورية الجديدة قادرة على جمع خيوط القرار الأمني في يد واحدة، فإننا قد نكون أمام مرحلة جديدة في تشكيل سوريا، مرحلة يتم فيها بناء جيش وطني جديد يحاكي النموذج التركي، مع إعادة تشكيل الولاء والعقيدة العسكرية بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية الحالية. هذه المرحلة لن تكون سهلة، لأن نجاحها يتطلب توافقًا سياسيًا داخليًا عالياً يتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية العميقة التي أسهم نظام الأسد في تفجيرها. ولكن، إذا نجحت سوريا الجديدة في إعادة بناء جيشها بشكل يتناسب مع التحديات الإقليمية، فإنها قد تنجح في تعزيز مكانتها في محيطها الجغرافي، إذا ما تم تضمين مبادئ من الاستقلالية العسكرية والتحكم الذاتي في قرارها الأمني.
من ناحية أخرى، فإن التفاهمات مع أنقرة، التي بدت أنها تؤتي ثمارها في الأشهر الأخيرة، تشير إلى تحول في العلاقات بين الطرفين، لا سيما في ظل التقارب الأمني التركي-السوري. تركيا تجد وتعتبر نفسها اليوم شريكًا ضروريًا للإدارة السورية الجديدة. لكن هذا التعاون لا يخلو من تحديات ومخاطر، خاصة في ظل حديث أنقرة عن إمكانية واحتمال تواجد دائم أو مؤقت على الأراضي السورية. ولا يخفى على أحد أن تركيا ترى في سوريا مجالاً لتثبيت نفوذها، وقد تتعامل مع هذه التفاهمات على أنها فرصة لتحقيق استراتيجيات أمنية تتجاوز محاربة “التنظيمات الإرهابية” لتصل إلى تعزيز قوتها في منطقة الشرق الأوسط.
أما روسيا، التي تعتبر اللاعب الرئيسي – سابقاً- في الملف السوري، فقد حافظت على وجودها العسكري والسياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، أرسلت رسائل مختلفة للإدارة السورية الجديدة وتراقب اليوم عن كثب كل تحرك للقوات التركية داخل الأراضي السورية، خصوصًا في المناطق التي تشكل نقطة تلاقٍ بين المصالح التركية والإيرانية. ومع تراجع الاهتمام الأميركي، تزداد أهمية الدور الروسي، الذي يبقى عائقًا أمام أي محاولات تركية للتوسع في المناطق الحساسة مثل الساحل السوري.
في هذا السياق، إن المرحلة التي تمر بها سوريا تتطلب إعادة هيكلة عميقة وشاملة ليس فقط للدولة بل للوعي أيضاً. وإذا استطاعت الإدارة السورية الجديدة جمع هذه الخيوط المتناثرة، فإنها قد تكون على أعتاب تشكيل جيش وطني قادر على التفاعل مع جميع القوى الكبرى في المنطقة، سواء كانت تلك القوى عربية أو غير عربية. وهذا البناء العسكري الجديد لن يكون مجرد رد فعل على الضغوط الخارجية، بل سيكون جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء سوريا جديدة تكون أكثر تماسكًا وأقل عرضة للانقسامات الداخلية.
سوريا اليوم تُشبه لوحة جغرافية متباينة الأطراف، تبحث فيها قوى إقليمية ودولية عن مصالح متباينة قد تكون متناقضة أحيانًا، لكنها تتقاطع في تفاصيل النزاع. من الشمال التركي إلى الجنوب السوري، مرورًا بظل أميركي يتقلص يوماً بعد يوم، ورقابة روسية سلبية، تظل سوريا تمثل ساحة اختبار حية للمصالح الإقليمية والدولية. بين الأطماع الإيرانية، والتحركات العسكرية التركية، والتفوق الإسرائيلي الأمني، تظل سوريا أرضًا منقسمة أكثر من كونها دولة واحدة قابلة للحكم والسيطرة. ورغم هذه التحديات، فإن سوريا ليست مجرد ساحة اختبار، بل قد تصبح ميدانًا يمكن أن يُعيد تشكيل قوة الدولة إذا توفرت شروط معينة يعرفها جيداً أصحاب القرار.
التاريخ علمنا أن الميادين التي تتنازعها القوى الكبرى قد تُنتج كيانات جديدة قادرة على النهوض. ففي غياب الدور الأميركي الفاعل، وقدرة روسيا على تقديم نموذج متوازن يعزز استقرارًا داخليًا، لا يوجد من يملأ الفراغ في سوريا سوى من يملك القدرة على فرض إرادته على الأرض. ويبدو أن هذا هو ما سيحدث في الفترة القادمة، حيث قد يؤدي الانسحاب الأميركي التدريجي إلى انكشاف حقيقة أن القوى الفاعلة على الأرض هي التي تكتب مستقبل سوريا. وعلى الرغم من ذلك، تبقى سوريا اليوم في موقع متأرجح بين التطلعات الوطنية والضغط الإقليمي، بين محاولات بناء جيش سوري جديد وبين تقاطع مصالح القوى الأجنبية التي تسيطر على أجزاء من أراضيها. مع كل قاعدة تُبنى، ومع كل طائرة تحلق في سمائها، ومع كل صفقة تُعقد خارج حدودها، تُكتب صفحة جديدة في كتاب تاريخ سوريا الذي سنكون شهوداً عليه. وما نريد أن نشهد عليه حقاً هو أن تنجح الإدارة السورية الجديدة في فرض نفسها كمحور أساسي على طاولة التفاوض الإقليمية، وإعادة بناء الدولة السورية ككيان متماسك وفاعل من دون قواعد عسكرية أجنبية أو انتهاك للسيادة.
تلفزيون سوريا
——————————————
حزب الله منتظراً على شرفة المفاوضات الأميركية – الإيرانية/ صهيب جوهر
2025.04.21
تراقب الأطراف الإقليمية والدولية التركيز اللبناني والأميركي الجاري في ملف سلاح حزب الله والحديث المستمر عن سحبه، وخاصة مع توافد المبعوثين الأجانب الى بيروت، وكان آخرها نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي حملت في جعبتها رسائل واضحة عن حزب الله وسلاحه، باعتباره وفق قولها “سرطان ينخر الجسد اللبناني”.
تراقب الأطراف الإقليمية والدولية التركيز اللبناني والأميركي الجاري في ملف سلاح حزب الله والحديث المستمر عن سحبه، وخاصة مع توافد المبعوثين الأجانب الى بيروت، وكان آخرها نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي حملت في جعبتها رسائل واضحة عن حزب الله وسلاحه، باعتباره وفق قولها “سرطان ينخر الجسد اللبناني”.
وبعيداً عن التحريض السياسي الحاصل بين حزب الله وخصومه في لبنان، والدخول في زواريب التنازع على المواقع السياسية، إلا أن الثابت في كل هذه المشهدية، هو التحولات الحاصلة في المنطقة، وخاصة في ظل المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي التقطها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بحديثه عن الحوار الثنائي بين الرئاسة اللبنانية من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، وخاصة أن النقاش الجاري مؤخراً عن تنازلات ستقدمها ايران في ساحات نفوذها السابقة تفتح الباب على دفع حزب الله للقبول بالوقائع التي أفرزتها الحرب من جهة، وسقوط نظام الأسد من جهة أخرى.
ولبنان الموضوع على لائحة اختبار دولية وإقليمية، دفع عون للحديث عن إمكانية استيعاب الجيش لعناصر حزب الله، لكن ليس عبر استنساخ تجربة الحشد الشعبي في العراق، وذلك قبيل زيارته التاريخية لدولة قطر، لأن الدخول في هكذا حسابات تحتاج لكثير من الدقة لحماية السلم الداخلي وخاصة أن التأثيرات السياسية والأمنية ما بعد الحرب لاتزال مؤثرة على الواقع الداخلي، على الرغم من كل المحاولات الحاصلة لإعادة تكوين السلطة وبناء الدولة.
لكن حزب الله بدأ الحديث عن مستلزمات للحوار على السلاح والانخراط في استراتيجية أمن وطني، معتبراً أن الممر الإلزامي لهكذا حوار يسلتزم انسحاباً إسرائيلياً من جميع الأراضي اللبنانية ومنع الخروقات والاغتيالات وتحريك ملف إعادة الإعمار، وهو بدوره سيبدي وفق ما يوحي إيجابية في سلاحه وسلاح المجموعات الأخرى، فلسطينية كانت أم لبنانية.
وهو ما يعني أن الحوار حول السلاح سيدخل في متاهات متشعبة، وخاصة أن الحزب يعول دائماً على يأس خصومه ومحاوريه المحليين أم الدوليين، وهذا السياق سيكشف ما سينتج من المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي ستكون حاسمة وستلامس النفوذ الإقليمي لإيران ومن ضمنه التركيبة العسكرية لحزب الله في لبنان، وجهازي الأمن والعسكر.
بالمقابل فإن الجانب الأميركي ينقل رسائل متعددة حول هذا الأمر، وخاصة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقل عن ترمب للوفد الإيراني وجود مهلة زمنية لإنجاز المفاوضات مع إيران لا تتعدى الثلاثة أشهر. ما يعني أن مهلة واشنطن لإيران تشمل حزب الله في لبنان، أي نهاية الصيف المقبل.
من هذا المنطلق بدا مرشد الثورة علي خامنئي يحاول الإيحاء بأنه يدير بشكل شخصي ومباشر ملف المفاوضات، وتصريح خامنئي أن المراحل الأولى من المحادثات سارت بنحو جيد، يمكن تفسيره بأنه إشارة على لمساته المباشرة على هذه المفاوضات. وهي نقطة يضيفها المتحمسون في إدارة ترمب على رؤيتهم لمسار المفاوضات والتي تدفعه إلى الاستنتاج بأن ظروف إيران السياسية تجعلها ملزمة بالتجاوب مع إدارة ترمب واعتماد الرضوخ الاضطراري للتوصل إلى اتفاق هي بأمس الحاجة إليها.
لكن الفريق المتأثر باللوبي الإسرائيلي في واشنطن لايزال يشكك بفرضية الوصول لاتفاق جدي مع إيران، وهو باشر بحملة تشكيك داخلية حيال جدية نية الحرس الثوري الإيراني والمرشد من عقد صفقة مع واشنطن، وخاصة أن كل التجارب السابقة مع طهران تشي بأنها تعتمد على مبدأ إهدار الوقت لإغراق المفاوضات بتفاصيل شائكة بهدف إمرار المرحلة وانتظار ظهور مشكلات داخلية أو دولية أمام ترمب ونتنياهو، وبالتالي اضطراره إلى وضع ملف إيران جانباً والتفرغ لملفات تشغل الداخل الأميركي أكثر.
لذلك عمدت القيادة العسكرية الأميركية إلى إرسال العديد من القطع العسكرية البحرية إلى الشرق الأوسط، تحسباً لتطورات غير متوقعة، إضافة لنقل قنابل ذكية جديدة لإسرائيل، وهي مؤشرات واضحة إلى أن الخيار العسكري هو وارد بشكل أساسي، لأنه ورغم كل الأجواء الإيجابية التي سادت عقب جولة السبت الماضي إلا أن نسبة الفشل لاتزال مرتفعة، وهو ما يعني أن كل الاحتمالات ستبقى واردة في المستقبل.
والأكيد أن الجولة التفاوضية الثانية غداً، قد تنتقل من المشروع النووي الى ملف الصواريخ الباليستية وساحات الوجود الإقليمي، وهو الشق المرتبط بلبنان، وخلال الأيام الماضية سربت طهران تصريحات لرويترز على لسان مصدر في الخارجية أنها لن تتفاوض عن حزب الله والحوثي، وأن على واشنطن أن تندفع للحوار معهم، لكن المعلومة المؤكدة أن إدارة ترمب ستفرض على إيران وقف جميع أشكال الدعم لحزب الله والحوثي وجماعات عراقية على مستويات مالية وعسكرية، ما يعني إضعافاً مباشراً لهذه المجموعات مهما بلغ حجمها السياسي على اعتبار أن الملف هو المرتكز الرئيسي للتأثير السياسي في لبنان.
وعليه يمكن استنتاج أن كل التوجه الأميركي الجديد في المنطقة يسعى لحسم الأمور مع خصومها، والتفاهم على ملأ فراغها مع حلفاءها، وهي اليوم تبحث على سبيل المثال عن حلول تمنع أي مواجهة عسكرية بين أنقرة وتل أبيب، في موازاة حماية الأطراف العربية المتعاونة معها ومنع انهيارها، كما هي الحال في الأردن ولبنان، وذلك في انتظار فهم الخريطة الجديدة التي تريدها لسوريا ومستقبل إيران، بعد تدمير أذرعها عن المشهد السياسي والتي صنعت الصورة السابقة للمنطقة
تلفزيون سوريا
——————————————
“لحماية سكان إسرائيل”.. نتنياهو يعلن إقامة “مناطق أمنية” في سوريا ولبنان
2025.04.20
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال أقام “مناطق أمنية” داخل الأراضي السورية واللبنانية، بهدف “حماية سكان إسرائيل”.
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة تناول فيها عمليات جيش الاحتلال في غزة، يوم أمس السبت، إنه أقام مناطق أمنية في سوريا ولبنان “لحماية سكان إسرائيل”.
ولم يقدم نتنياهو تفاصيل إضافية، علماً بأن الاحتلال كان قد بدأ، منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، بالسيطرة على أجزاء من المنطقة العازلة جنوبي سوريا، وتنفيذ عمليات توغل في أرياف درعا والقنيطرة ودمشق.
كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على التزام حكومته بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معتبراً أن هذا الهدف جزء من الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية في المنطقة.
نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب على غزة
تعهد نتنياهو بمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى القضاء الكامل على حركة حماس، وفق تعبيره، رافضاً أي دعوات داخلية لوقف الحرب مقابل صفقة تبادل أسرى.
وأكد أن حكومته “لن تقبل إلا بإعادة جميع المحتجزين والقضاء على حركة حماس”، معتبراً أن من يطالب بإنهاء الحرب داخل إسرائيل “يروج لدعاية حماس ويخدم حربها النفسية ضد الإسرائيليين”.
وأضاف أن حركة حماس رفضت مؤخراً عرضاً بالإفراج عن نصف المختطفين، الأحياء والأموات، مقابل إنهاء الحرب، واصفاً قبول هذا العرض بأنه كان سيعني “هزيمة إسرائيل”، وفق قوله.
وفي معرض حديثه عن الأسرى، زعم نتنياهو أنه “يتفهم معاناة عائلاتهم”، مضيفاً أنه سيسعى لزيادة الضغط العسكري على حماس لتحقيق جميع أهداف الحرب، مع التأكيد على أن إعادة المحتجزين ممكنة دون الاستجابة لشروط الحركة.
واعتبر أن الإخفاق في القضاء على القدرات العسكرية لحماس قد يؤدي إلى تكرار أحداث السابع من تشرين الأول، وهو اليوم الذي شهد بداية الحرب الحالية.
ضغوط متزايدة على حكومة الاحتلال
شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة، يوم أمس السبت، تطالب بإبرام صفقة تبادل تفضي إلى إعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، وسط تزايد الضغط الشعبي على الحكومة لوقف الحرب وإتمام الاتفاق.
ونُظّمت الاحتجاجات تحت شعار “لم يتبقَ لنا سوى دفعة واحدة”، في إشارة إلى ضرورة السعي لصفقة شاملة تشمل استعادة جميع المختطفين.
بدورها، أصدرت هيئة عائلات الأسرى بياناً أكدت فيه أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مقابل استعادة جميع الأسرى، محمّلة نتنياهو مسؤولية التأخير في تحقيق هذا الهدف.
يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استأنف، فجر الثامن عشر من آذار الفائت، عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بذريعة رفض حركة حماس مقترحات أميركية لتمديد وقف إطلاق النار.
—————————–
قوات الطوارئ الدولية عاجزة أمام التوغلات الإسرائيلية في سورية/ محمد أمين
20 ابريل 2025
قدور: القوات الأممية في جنوب سورية غير قادرة على أداء مهامها
تتزايد التوغلات الإسرائيلية في سورية منذ إسقاط نظام الأسد
شنت إسرائيل أكبر حملة قصف جوي دمّرت كل المقدرات العسكرية السورية
تتزايد التوغلات الإسرائيلية في سورية والتي تتخذ منى تصاعدياً منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتحولت التوغلات الإسرائيلية في سورية إلى نمط يومي من الاعتداءات في عدد من القرى، على غرار ما جرى قبل أيام عندما نفذت قوات إسرائيلية عمليات توغل ومداهمة لليوم الثاني على التوالي في قرية الحميدية، في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي، جنوبي سورية. في المقابل، فشل رتل من قوات الفصل التابعة للأمم المتحدة في جنوب سورية، الأربعاء الماضي، من الوصول إلى ثكنة عسكرية سورية استولت عليها إسرائيل بعد أيام قليلة من سقوط نظام الأسد.
وذكرت شبكات إخبارية محلية، ومنها “تجمع أحرار حوران”، أن رتلاً عسكرياً تابعاً للأمم المتحدة دخل، الأربعاء الماضي، إلى السهول الزراعية في قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، باتجاه ثكنة الجزيرة العسكرية التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية معرية، إلا أنه لم يدخل إليها، بسبب منعه من جنود الاحتلال. وكان الجيش الإسرائيلي قد استولى على هذه الثكنة القريبة من الحدود السورية مع هضبة الجولان المحتلة، بعد يومين فقط من سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، واتخذ منها نقطة تمركز وانطلاق لتنفيذ عمليات توغل في عمق الجنوب السوري في ريفي درعا والقنيطرة.
استمرار التوغلات الإسرائيلية في سورية
في سياق استمرار التوغلات الإسرائيلية المتزايدة في سورية، ذكر المتحدث باسم “تجمع أحرار حوران” أيمن أبو نقطة، في حديث مع “العربي الجديد”، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت، قبل نحو أسبوع، برفقة عدد من السيارات، في أطراف تل أحمر الشرقي، المحاذي لتل أحمر الغربي، الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال قبل نحو شهر. وأشار إلى أن التلين يقعان شرقي بلدة كودنا في ريف القنيطرة. وارتكبت قوات الاحتلال أكثر من مجزرة بحق السكان المحليين في ريف درعا أثناء توغلها فيه، تحت ذرائع أمنية أكدت الوقائع الميدانية زيفها، خصوصاً أن سورية أعلنت على لسان كبار المسؤولين فيها، أنها ليست بصدد الدخول في نزاعات مع دول الجوار.
وتعليقاً على عدم قدرة القوات الدولية التحرك بحرية في الجنوب السوري، أوضح الخبير العسكري ضياء قدور في حديث مع “العربي الجديد”، أن القوات الأممية في جنوب سورية “ضعيفة وغير قادرة على أداء مهامها”. ولفت قدور إلى أن الاحتلال استولى على ثكنة الجزيرة بعد إرهاب السكان. وتابع: انطلاقاً من هذه الثكنة أطلقت القوات الإسرائيلية النار على قرية كويا، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. واعتبر أن التوغلات الإسرائيلية في سورية واعتداءات الاحتلال “تزداد حماقة”، مضيفاً: لدى إسرائيل مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من شمال شرقي سورية، لذا تسرّع تنفيذ خطط توسعية وعدوانية وقضم أراض جديدة بشكل غير شرعي في الجنوب السوري.
من جانبه، أوضح المحلل العسكري مصطفى فرحات في حديث مع “العربي الجديد”، أن قوات الطوارئ الدولية الموجودة في منطقة الجولان السوري “دورها ليس عسكرياً رادعاً بل رقابي”، مضيفاً أنها وُجدت لتراقب التجاوزات من الجانبين على الاتفاق الدولي، وعندما تندلع الحروب تُعطى الأوامر لهذه القوات للإخلاء. وعندما يكون دور قوات الطوارئ الدولية هو المراقبة والتوثيق يعني أنها لا تستطيع فرض إرادة على أي طرف من أطراف النزاع. وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفاً من بين حكومات الكيان الصهيوني، وشُكلت من أحزاب متشددة، لذا من الطبيعي أن تقوم بالتمدد في الجنوب السوري، وعرقلة إقامة قاعدة عسكرية جوية تركية في مطار “تي فور” بريف حمص.
وأشار فرحات إلى أن نتنياهو “يريد سورية مستباحة لجيشه في البر والبحر والجو من دون أي رادع”، مضيفاً: لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تفكر في سحب قواتها من الأراضي التي استولت عليها بعد إسقاط نظام الأسد، في ظل عدم وجود جيش سوري قوي. سورية ليست بصدد خوض حروب جديدة. وبيّن أن “استيلاء الكيان الصهيوني على مرصد جبل الشيخ يعني أنه لم يعد لنا قدرة على رصد التحركات العسكرية الإسرائيلية”، مضيفاً أن البنية العسكرية السورية مدمرة للأسف في الوقت الراهن.
استيلاء الاحتلال على المنطقة العازلة
وأعلن نتنياهو بعد يوم واحد من سقوط نظام الأسد، الذي حافظ على هدوء الجبهة مع إسرائيل 50 عاماً، انهيار اتفاق “فض الاشتباك” مع سورية، وأمر جيشه بالاستيلاء على المنطقة العازلة، حيث تنتشر قوة الأمم المتحدة. كما استولى جيش الاحتلال على مواقع خارج المنطقة العازلة، أبرزها أعلى قمّة في جبل الشيخ، الحاكمة لأجزاء واسعة من الجغرافية السورية. كما شنت تل أبيب أكبر حملة قصف جوي دمّرت خلالها كل المقدرات العسكرية السورية التي خلّفتها قوات النظام المخلوع، في محاولة لإضعاف الدولة السورية
والحيلولة دون تشكيل جيش سوري جديد ينتشر في المواقع التي كانت تتمركز فيها القوات المنحلّة، وفق اتفاقية دولية. وكان نظام الأسد الأب (حافظ)، قد وقّع في مايو/أيار 1974 “اتفاقية فك الاشتباك” مع الجانب الإسرائيلي، التي نصّت على أن “إسرائيل وسورية ستراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة”. حددت الاتفاقية بالتفصيل أماكن قوات النظام والجانب الإسرائيلي، ومنطقة الفصل بينهما والتي تبلغ مساحتها حوالي 235 كيلومتراً مربعاً، ورابطت بها منذ ذلك الحين قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة يبلغ عددها 1200 عنصر.
العربي الجديد
—————————–
“التجمع الوطني في السويداء”.. كيان سياسي جديد في مشهد ضبابي ومنقسم
21 أبريل 2025
عُقد السبت الفائت، في قصر الثقافة بمدينة السويداء، مؤتمر تأسيسي لما سُمّي “التجمع الوطني في السويداء”، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والعسكرية من أبناء المحافظة.
ويأتي الإعلان عن تأسيس هذا التجمع بعد مشاورات وجولات قام بها الأعضاء المؤسسون في عدد من القرى والمدن والنواحي بمحافظة السويداء، بهدف التوصل إلى رؤية واحدة وجسم سياسي واحد يمثّل رؤية المحافظة وتطلعاتها، وفق ما أفاد به القائمون عليه.
تواصل موقع “الترا سوريا” مع أحد مؤسسي التجمع، فضل عدم الكشف عن اسمه في الوقت الراهن، وقال إن التجمع يهدف إلى: “وحدة الدولة السورية ووحدة التراب السوري، لكننا نرى أن الحكومة الحالية، التي يغلب عليها “طيف واحد”، أنها لا تعكس تطلعات الشعب السوري”.
وأضاف أن التجمع: “يهدف إلى أن تكون السويداء شريكة في التمثيل السياسي وصنع القرار الوطني، أسوةً بباقي محافظات البلاد، سواء من حيث التمثيل في مجلس الشعب المرتقب، أو من خلال ضرورة تعيين محافظ من أبناء السويداء، أسوةً بباقي مكونات الشعب السوري، دون إقصاء أو تمييز”.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية: “أعطت وزارة واحدة للسويداء، وأخرى للطائفة المسيحية، وثالثة للأكراد، وذلك من دون أي ثقل وزاري من حيث التمثيل والفعالية”. وتابع: “إننا نطمح إلى أن تكون الحكومة تشاركية لجميع مكونات الشعب السوري، تحت سقف الوطن الواحد”.
وأكد أن المؤتمر: “في حال حصوله على التأييد الشعبي والقبول المجتمعي، سيبدأ بتوسعة نشاطاته ولقاءاته لتشمل باقي التيارات والأحزاب السياسية المتواجدة داخل محافظة السويداء، بالإضافة إلى باقي محافظات البلاد”.
وأوضح المصدر أن: “أعمال المكتب السياسي للتجمع انطلقت منذ ما يقارب أربعة أشهر، حيث بدأ بزيارة قرى ومدن محافظة السويداء، وذلك لاستقطاب الكوادر السياسية والاجتماعية في المحافظة. كما تم دمج المكتب السياسي مع مكتب “تمثيل عسكري” يضم عددًا من الضباط وصف الضباط الذين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة، تحت قيادة اللواء عادل قيصر، وذلك بهدف الإشراف على الفصائل المحلية ومحاولة جمعها تحت إدارة واحدة”.
وأعرب عن رفض التجمع لتوجه “المجلس العسكري” الذي يقوده العقيد طارق الشوفي، مؤكدًا عدم وجود أي تنسيق معهم، وذلك بسبب: “عدم المصداقية والحالات الجدلية التي أثارها المجلس العسكري منذ تأسيسه”.
ومن ناحية أخرى، أكد المصدر أنهم طرحوا الفكرة على الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، الذي رحّب بفكرة وجود ضباط للإشراف على عناصر الفصائل، نظرًا لاختلاف نظرة الضابط عن نظرة العاملين في الفصائل المحلية، ولخبرتهم في إدارة الشؤون العسكرية داخل محافظة السويداء.
وفي وقت سابق، قال سلمان الهجري، نجل الشيخ حكمت الهجري، في تصريحات صحيفة، إن والده لم يبارك هذا التجمع، ولم يصدر أي بيان يؤكد دعمه له.
في المقابل، أكدت مصادر محلية أن الهجري يستقبل كافة التيارات والأحزاب السياسية في محافظة السويداء “إيمانًا منه بالتعددية السياسية واختلاف وجهات النظر”، مشيرةً إلى أن أي موقف رسمي يصدر عنه يكون فقط عبر صفحة “الرئاسة الروحية”.
ومن جهة أخرى، دعا تيار “الحرية والتغيير”، الذي ُشكّل منذ انطلاقة الحراك السلمي في محافظة السويداء عام 2023 ، كوادره ومنتسبيه إلى الاجتماع يوم السبت القادم، بهدف بلورة رؤية واضحة وصريحة للتيار في ظل التحديات والتخبطات السياسية التي تعيشها محافظة السويداء.
ويبقى المشهد السياسي في المحافظة الجنوبية يتسم بالضبابية، وعدم القدرة على بلورة موقف موحد وجامع لأطيافها حتى الآن، وسط محاولات حثيثة من الهيئات الدينية والاجتماعية لضبط حالة الانقسام السياسي داخل المحافظة.
——————–
قوات الاحتلال تتوغل مجددًا في ريف القنيطرة وتنفيذ عمليات تفتيش
21 أبريل 2025
شهدت قرية العشة في ريف القنيطرة، فجر اليوم، دخول رتل مؤلف من سيارات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قادمًا من الجولان السوري المحتل، وفقًا لمصادر محلية.
وأفادت صفحات إخبارية محلية بأن القوات المتوغلة نفذت عمليات تفتيش داخل أحد المنازل، بالتزامن مع تحذيرات بثتها عبر مكبرات الصوت، طالبت فيها الأهالي بعدم مغادرة منازلهم.
وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من عملية التفتيش، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى موقعها العسكري في تل أحمر الغربي الذي تحتله إسرائيل منذ مدة.
وأفاد مراسل “الترا سوريا”، في وقت سابق، بدخول مجموعة من سائقي الدراجات النارية إلى الأراضي السورية عبر نقطة المعبر في ريف القنيطرة الأوسط. وبحسب مراسلنا، اتجهت الدراجات إلى سد المنطرة، دون أن تحدد هويتهم وما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.
وفي الفترة الأخيرة، عززت إسرائيل من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المناطق الجنوبية، سواء عبر التوغل العسكري المستمر، أو من خلال تصريحات قاداتها المستفزة.
وبالتزامن مع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، استغلت إسرائيل الفرصة وسارعت إلى لتوغل في جنوب سوريا، حيث احتلت جبل الشيخ والمناطق المحيطة به.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقعة عام 1974، بحجة انسحاب قوات الجيش السوري من مواقعها، مطالبًا قواته بالسيطرة على منطقة جبل الشيخ لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل، على حد قوله.
ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل شنت غارات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، من بينها مواقع إستراتيجية، وأنظمة صواريخ متقدمة، ومنظومات دفاع جوي، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر، إضافةً إلى مخازن الأسلحة الكيميائية، ومصانع ومعاهد بحثية عسكرية.
———————–
==========================
الحكومة السورية الانتقالية: المهام، السير الذاتية للوزراء، مقالات وتحليلات تحديث 21 نيسان 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
——————————————
سورية… متلازمة الفساد والدخل/ عبسي سميسم
20 ابريل 2025
لعل الشعار الأبرز الذي طرحته الحكومة السورية الجديدة (تسيير الأعمال، والحكومة الانتقالية)، وتطبّقه بفعالية هو شعار مكافحة الفساد، كون الميزة الأساسية (لحكومة الإنقاذ التي استلم معظم أعضائها مفاصل الحكومة السورية) أنها كانت تمتلك منظومة إدارية شبه خالية من الفساد. كما أنها كانت صارمة مع أية حالة فساد.
إلا أن تطبيق هذه الصرامة في المناطق التي كان يديرها نظام بشار الأسد، أدت إلى مفاعيل سلبية أثرت على حياة غالبية السوريين، خصوصاً الموظفين الذين لم يعد لديهم القدرة على تأمين أدنى متطلبات حياتهم اليومية، بسبب منظومة الفساد التي هندسها النظام السابق، بطريقة تسمح للجميع بسرقة وابتزاز الجميع. منظومة يتمكن فيها مواطن لا يتجاوز دخله الشهري 30 دولاراً أميركياً من تأمين متطلبات حياته اليومية، بدءاً من المستخدم وانتهاء بالوزير.
إذا تجاوزنا كبار الفاسدين، وبحثنا في منظومة الفساد المعقدة على مستوى المواطنين العاديين، نجد أن المستخدمين في أي دائرة حكومية ينقسمون إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى مدعومة من فاسد لدى جهة عليا والمشمولون فيها مسجلون على قيود الموظفين مقابل نسبة من راتبهم دون دوام، وبالتالي لديهم عمل آخر يحصلون من خلاله على مورد. وفئة تتطلّب طبيعة عملها احتكاكاً مع المواطنين، وهذه الفئة تحصل على أضعاف راتبها من المواطنين، سواء كانوا مراجعين لدوائر حكومية أو مشاف وغيرها. وفئة ثالثة من المستخدمين الذين يعملون كمفاتيح لموظفي الدائرة التي يعملون فيها مقابل نسب من الرشى التي تدفع لتمرير معاملة ما.
أما بالنسبة إلى موظفي الدرجة الثانية والثالثة في الدوائر الحكومية فإن جميع معاملات الدولة لا تُمرَر دون دفع تسعيرة لكل معاملة، بدءاً من اختصار الوقوف على الطابور وانتهاء بتمرير المعاملة ذاتها. طبعاً هذا عدا عن الاختراعات التي يبتدعها الموظفون لعرقلة المعاملات وحلها مقابل المال. فمثلاً في مديريات الاتصالات تُقطع مجموعة من خطوط الهاتف الأرضي عن عدد من المشتركين دورياً، والتي تتطلب إعادة وصلها دفع مبلغ بين 25 إلى 50 ألف ليرة سورية (الدولار يساوي 11 ألف ليرة)، وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء والماء وغيرهما من الخدمات.
ولا يختلف الأمر في باقي القطاعات، فصحافي لا يتجاوز راتبه 350 ألف ليرة كان غير ملزم بدوام ويعتمد على الهبات من المسؤولين مقابل إما مدح مسؤول ما وإما التجاوز عن فساد مسؤول. وعادة ما يلجأ صحافيون لابتزاز مديري الدرجة الثانية لتأمين دخل إضافي، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي القطاعات التي نجد أن النظام السابق أوجد “حلاً” لمشكلة تدني الرواتب فيها من خلال الفساد. أما الآن فيعاني معظم موظفي قطاعات الدولة من انقطاع الدخل الإضافي المتأتي من الفساد، بالتأكيد ليس المطلوب عودة الفساد وإنما أن تجد الحكومة حلولاً لموضوع الدخل مترافقة مع القضاء على هذه المنظومة من الفساد.
العربي الجديد
——————————————
حل “لواء العودة”… هل تبدأ دمشق حملة توحيد الجيش السوري؟/ حايد حايد
لا يمكن اعتبار ما حدث مع قوات العودة نموذجا قابلا للتعميم
آخر تحديث 21 أبريل 2025
شكّل حل اللواء الثامن، بقيادة أحمد العودة، في 13 أبريل/نيسان، نقطة تحول بارزة في المشهد الأمني السوري، إذ أزاح الرئيس المؤقت أحمد الشرع خصمه الأبرز في الجنوب، وفتح المجال أمام دمشق لتعزيز قبضتها على محافظة درعا.
وربط مراقبون هذه الخطوة بزيارة الشرع الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تجمعها بالعودة علاقات وثيقة. وعلى الرغم من أن التوافق الإقليمي ساهم في تسهيل العملية، فإن العامل الحاسم كان في الاستراتيجية الميدانية المحكمة التي انتهجتها دمشق.
فقد اتبعت الحكومة الانتقالية نهجا بات مألوفا بالنسبة لها، فبادرت إلى بناء مراكز قوة بديلة، ثم شرعت في عزل اللواء وإضعافه بشكل تدريجي، قبل أن توجه الضربة النهائية في الوقت المناسب، عبر مزيج مدروس من التهديد العسكري والضغوط المجتمعية. ثم تكللت هذه المقاربة باتفاق تفاوضي أدى إلى تفكيك اللواء دون أن تندلع مواجهات دامية تُذكر.
ويحاكي هذا النهج إلى حد كبير أسلوب “هيئة تحرير الشام” في تصفية خصومها بإدلب ومناطق الشمال السوري، ما يطرح تساؤلا جوهريا: هل تعتزم دمشق تطبيق الآلية ذاتها لاستيعاب بقية الفصائل المسلحة، التي تخضع شكليا لوزارة الدفاع، ضمن هيكل القوات النظامية الخاضعة بالكامل للدولة؟
تصاعد التوترات والانهيار
وكان اللواء الثامن قد حافظ، كغيره من الفصائل التي وافقت على الاندماج تحت قيادة وزارة الدفاع، على درجة غير مسبوقة من الاستقلالية في اتخاذ القرار، ولكنه انفرد بموقفه الصارم الرافض لتمركز أي قوات غير محلية موالية لدمشق في معقله بمدينة بصرى الشام.
وازدادت التوترات حدة بعد فشل المفاوضات المتعلقة بدمج اللواء في البنية العسكرية الرسمية، إذ تحولت الخلافات بشأن توزيع الرتب، وترسيم مناطق النفوذ، وتحديد الصلاحيات، إلى أزمة ثقة متفاقمة، حالت دون ترسيخ نفوذ دمشق في درعا.
وانتهجت الحكومة الانتقالية، على غرار “هيئة تحرير الشام”، سياسة القضم التدريجي لنفوذ اللواء، من خلال عزله وتوسيع شبكة تحالفاتها المحلية. وجاءت الخطوة المفصلية بتعيين بنيان أحمد الحريري- وهو من أبناء المنطقة وينتمي إلى عائلة ذات وزن عشائري- على رأس الفرقة العسكرية في المحافظة، ما أفضى إلى تحييد مجموعات كانت تشكل ركيزة أساسية في قوة العودة.
وفي مسعى موازٍ، اخترقت دمشق معقل العودة ببصرى الشام بدعمها للمنافس المحلي بلال الدروبي، الذي كُلّف بإنشاء خلية تابعة للأمن العام، بهدف تقويض هيمنة العودة وتعزيز حضور الدولة في المنطقة.
وقد أسفرت هذه الإجراءات، إلى جانب عوامل أخرى، عن تآكل ملحوظ في قوة اللواء الثامن، الذي انكمشت عناصره إلى ما بين 300 و400 مقاتل فقط، محاصرين في جيب بصرى الشام، ومعزولين تدريجيا عن حلفائهم الإقليميين وشبكات دعمهم الخارجية.
الضربة القاصمة
بلغت استراتيجية دمشق ذروتها في لحظة مدروسة، حين اختارت تفجير الأزمة في توقيت محسوب بعناية. وكانت الشرارة الأولى مواجهة مسلحة اندلعت بين قوات أحمد العودة وبلال الدروبي، تحت غطاء عملية لمكافحة المخدرات. لكن التحول الفاصل وقع عندما قُتل الدروبي خلال الاشتباكات، وهو ما أثار غضب أنصاره وأشعل موجة من المواجهات العنيفة.
اغتنمت دمشق الفرصة، فدفعت بـ1200 عنصر من قوات الأمن العام إلى أطراف بصرى الشام، في استعراض قوة ينذر بعملية عسكرية وشيكة. لكنها بدلا من اللجوء الفوري إلى السلاح، فتحت قنوات تفاوض مع وجهاء المنطقة. ولتعزيز الضغط الشعبي، تأخر دفن الدروبي، فيما استُخدمت المساجد لتنظيم مظاهرات تندد باللواء الثامن.
وتحت الضغط المجتمعي الغاضب، وفي ظل التهديد بتدخل عسكري، رضخ قادة اللواء الثامن للأمر الواقع. وفي 13 أبريل/نيسان، وافقوا على شروط تضمنت نزع السلاح، وتسليم السيطرة الأمنية لقوات الأمن العام، وتعيين قائد مؤقت للإشراف على دمج اللواء في هيكل وزارة الدفاع. وبذلك، طُويت صفحة النفوذ الذي مثّله أحمد العودة في المنطقة.
نموذج محتمل أم سابقة استثنائية؟
يمثل نجاح دمشق في تفكيك اللواء الثامن، باستخدام أدوات سياسية وميدانية تحاكي أساليب “هيئة تحرير الشام”، سابقة قد تُستنسخ في التعامل مع فصائل أخرى ترفض الاندماج الكامل في صفوف الجيش النظامي. غير أن مدى فعالية هذه الاستراتيجية يظل مرهونًا بثلاثة عوامل حاسمة: حجم الفصيل المستهدف، عمق ارتباطه الاجتماعي، ومستوى الشرعية التي تتمتع بها الحكومة المركزية في نظر المجتمعات المحلية.
ولا يمكن اعتبار ما حدث مع قوات العودة نموذجا قابلا للتعميم. فحين تقتضي الضرورة، قد تلجأ دمشق إلى الحسم العسكري المباشر لسحق أي مقاومة وفرض التفاوض بشروطها.
لكن، حتى إذا نجحت هذه المقاربة في توسيع رقعة السيطرة الحكومية، فإن الأزمة السورية العميقة تبقى عصية على المعالجة بتلك الوسائل وحدها. فالمطالب الأساسية للفصائل المعارضة المترددة– وفي مقدمتها اللامركزية، ورفض هيمنة “هيئة تحرير الشام” على القرار السياسي، والمطالبة بتقاسم فعلي للسلطة– تظل غير قابلة للتجاوز بالضغط والإكراه.
ويظل الغليان الاجتماعي كامنا تحت السطح، مثل بركان خامد، ما دامت قنوات الحوار الجاد مغلقة، وما دام دور الفاعلين السياسيين شكليًا. وعندما تُهمّش الأصوات، يصبح الانفجار مسألة وقت، لا نتيجة أيديولوجيات، بل حصيلة يأس متراكم، ونظام سياسي أخفق في أن يكون أداة تغيير حقيقية.
المجلة
——————————–
الثقافة السورية في العهد الجديد/ بشير البكر
الإثنين 2025/04/21
لا يبدو أن مستقبل الثقافة السورية سيكون بخير مع الوزير الجديد محمد صالح، الذي قدم نفسه في حفلة تنصيب الحكومة السورية، وأقسم اليمين الدستورية بأبيات من الشعر ذات رؤية سياسية على قدر من الخفة، وتفتقر إلى العمق والرصانة التي يجب أن يتحلى بها المسؤول، عندما تضعه الأحداث أمام مهمة تنوير الناس في الأزمنة الصعبة والاستثنائية، ومنهم أهل بلدنا سوريا، التي عانت في العقود الأخيرة من محاولات تجفيف منابع الثقافة، وتحويل البلد إلى صحراء في عمل ممنهج لتجهيل السوريين، وفرض حالة من الأمية الثقافية على مجتمع، ظلت الثقافة، عبر تاريخه الطويل، أحد أسلحة دفاعه عن هويته الوطنية.
سوريا بلد ثقافي بامتياز، ولها دور رائد في اغناء الثقافة العربية وتجديدها، منها ظهر شعراء كبار مثل نزار قباني، وعمر أبو ريشة، وبدوي الجبل، ومحمد الماغوط، وروائيون متميزون مثل حنا مينه، وقصاصون مجددون كزكريا تامر، ومفكرون تنويرون كصادق جلال العظم، ورسامون مثل لؤي كيالي وفاتح المدرس ونذير نبعة، وكتاب مسرح كسعد الله ونوس، وسينمائيون كمصطفى العقاد.
مضى قرابة ثلاثة أسابيع على تسلم وزير الثقافة الجديد مهامه، وكان من المنتظر منه أن يقدم تصوره لما يمكن أن تقوم به الوزارة من عمل عاجل لإسعاف المؤسسات الثقافية العاطلة عن العمل، أو على الأقل زيارة المسارح المغلقة مثل الحمرا والقباني والخيام، التي شهدت نهضة سوريا المسرحية، وصالات السينما كالكندي، التي تشكل فيها الوعي والثقافة السينمائيين لأجيال سورية في السبعينيات والثمانيات، أو المراكز الثقافية، أو أن يلتقي بما بقي داخل سوريا من مثقفين، صمدوا خلال الحقبة الأسدية السوداء ودفعوا ثمنا كبيرا للدفاع عن ثقافة وهوية السوريين.
اقتصرت نشاطات الوزير على زيارة لضريح الشيخ الشيعي محسن الأمين ومقام السيدة زينب، في 17 نيسان يوم استقلال سوريا، وأخرى جرى نشر صورها على وسائل التواصل لشيخ عشائري من البوكمال بريف دير الزور، يدعى فرحان المرسومي، وذلك برفقة جمال الشرع شقيق رئيس الدولة، وهذا من حقه، ولكن وسائل التواصل حفلت بأخبار وصور عن هذا الشيخ، الذي تحدث ناشطون أنه كان مهرب “كبتاغون”، وأحد أذرع الحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال، والفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد. وإن ذل ذلك على شيء فهو يعبر عن عدم مراعاة مشاعر الناس، قبل خدش مكانة الموقع الذي يتولاه كممثل للدولة وللشأن العام أولا، وكوزير للثقافة ثانيا، التي تتطلب من الرجل التي يقودها أن يتوافر على قدر عال مما يتحلى به المثقف من نزاهة واحترام للناس.
لا ينتظر السوريون ثقافة مَضافات، وعباءات عشائرية، واستعراضات في وسائل التواصل، بل ثقافة اختلاف وتجديد. أي وزير يتسلم هذا المنصب، يجب ألا يكون أقصر قامة من الوزيرة نجاح العطار صاحبة الدور المشهود له في نهضة سوريا ثقافيا في الثمانينات. ولذا يجب أن تسند المهمة في العهد الجديد إلى شخص يمتلك ثقافة حقيقية، ورؤية تليق بسوريا الجديدة.
تحتاج سوريا اليوم إلى ثقافة تقطع مع العهد البائد، ليس على أساس الترويج لمقولات وخرافات شعبوية، تتوسل كسب متابعين على وسائل التواصل، بل على أساس مفاهيمي فعلي يضع الثقافة في مكانها الصحيح في المجتمع، من كونها أحد مصادر المناعة والإعلاء من قيمة الوعي في حياة الناس، الذين تعرضوا على مدى عقود إلى عمليات اضطهاد ثقافي، لا يقل قسوة عما حصل سياسيا، حيث تم اغراق البلد بالدراما الرديئة، والمسلسلات الهابطة، والكتب السطحية، وتحولت المؤسسات الثقافية إلى مراتع للأمن، ورديف للمؤسسات القمعية، وهذا واضح في حال اتحاد الكتاب، الذي اداره بعض موالون للنظام السابق، ومنهم نضال الصالح، الذي تم طرده من التدريس الجامعي، بسبب تزوير شهادته العلمية، واستقال من رئاسة الاتحاد عام 2019، نتيجة حملة قادها ضده أعضاء من الاتحاد اتهموه بالتعامل بعقلية الشبيح، الذي استبعد أي كاتب لا يتفق معه شخصياً بزعم أنه متآمر ومناهض للنظام، حتى لو كان مؤيداً.
هناك ظواهر غير مبشرة مثل تعيين لجان لتسيير بعض المؤسسات، نقابة الفنانين، نقابة التشكيليين، واتحاد الكتاب، وقد صدر ذلك عن جهة رسمية تابعة لوزارة الخارجية تدعى أمانة الشؤون السياسية، التي بات من المتعارف أنها هيكل سياسي جديد، تعتمده السلطة كجهاز للحكم. ويرى معارضو ذلك أن الانتقال إلى وضع جديد، لا يتم من خلال تكريس أساليب عمل السلطة السابقة، أو استنساخ طرق عملها، أو تقليدها، ويجب ألا يقتصر الأمر على الهياكل، بل الأفراد أيضا. ومن المنتظر أن يكون الأشخاص في المواقع الأمامية معبرون عن الروحية الجديدة للبلد المدمر، والذي لا يملك سوى الرصيد الأخلاقي الكبير، الذي كونه بفضل صموده وتضحياته وصبره وتشرد أبنائه في معركة الخلاص من الطغيان. وعلى هذا ليس من الحصافة بمكان الاستهانة بالسوريين أو الاستخفاف بوعيهم، أو التأثير عليهم بأساليب وشعارات تجرهم الى الوراء، واستغلال الهشاشة الاقتصادية وحال التعب الذي يعيشونه.
تنهمك فئات واسعة من المثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال والفنانين والمؤثرين على وسائل التواصل، بالدفاع عن التحول السوري الذي حصل في الثامن من كانون الأول، لكن العديد من الذين يتولون مناصب رسمية في السلطة الجديدة، ليسوا على قدر من الوعي بالتحديات التي تواجه البلد، على طريق استكمال وحدته الداخلية، وبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة.
المدن
——————————————
ثنائية الجيش والفصائل/ لمى قنوت
أفواج من الجهاديين من مختلف المشارب عبروا وقاتلوا في سوريا، كـ”حزب الله” الذي تدخل في عام 2012 إلى جانب مجموعات أخرى قاتلت دفاعًا عن النظام البائد، وخرجت أو أُخرجت من البلاد إثر الحرب على وكلاء إيران في لبنان وسوريا، إضافة إلى جهاديي “داعش” و”القاعدة” وغيرهما من الجماعات العقائدية التي ما زال جزء من عناصرها محتجزًا في سجون “الهول” و”روج”، أما الجماعات التي انضمت إلى عملية “ردع العدوان” التي أدت إلى فرار الأسد، فقد تم تعيين بعضهم وتقليدهم مناصب قيادية في الجيش، واليوم تضع واشنطن شروطًا من ضمنها إبعادهم عن تلك المناصب لتخفف العقوبات التي تعوق إنعاش الاقتصاد المنهار.
على صعيد السلطة الجديدة، فقد أرادت لقرارات فصائل “ردع العدوان” أن يكون مؤتمرها “مؤتمر النصر” بمثابة مؤتمر تأسيسي لمرحلة ما بعد النظام الأسدي، وربما، من هنا يُفهم لماذا تتجاهل السلطة الدعوة لعقد مؤتمر وطني جامع، الأمر الذي جعل من التشاركية والحوار والمشاورات تقتصر على “تيارها السياسي” من شرعيين ومقاتلين ومدنيين، ويُفسر أيضًا الطريقة الأدائية التي اختُزل فيها مؤتمر الحوار الوطني لساعات معدودة، والتي قدرت بخمس ساعات، وإغفال مخرجاته أهمية بناء القطاع الأمني، وبضمنه الجيش، في البند العاشر المتعلق بالعدالة الانتقالية، والاكتفاء بالتنصيص على إصلاح المنظومة القضائية فقط، رغم أهميتها في المراحل الانتقالية، والاقتصار على جملة عامة وردت في البند الثالث المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة والذي تضمن جملة “بناء جيش وطني احترافي”.
وفي الواقع، إن بناء جيش بمعطيات الإدارة الحالية، التي تستفرد بتأسيسه وفق أجندتها وخلفيتها الأيديولوجية، القائمة على تقاسم السلطة بناء على الولاء، هو تعيين جهاديين أجانب، بعضهم مطلوبون في دولهم، وقادة خاضعون لعقوبات دولية، وتعيين متورطين في صراعات خارج سوريا، كفهيم عيسى قائد فرقة “السلطان مراد” فيما يُسمى “الجيش الوطني” عبر تجنيد مقاتلين ومدنيين للقتال في النيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو بدعم تركي، إضافة إلى النفوذ الخارجي وتبعية القرار للعديد من الفصائل، والعقلية الغنائمية وتقاطعها مع الفساد، وبذلك نكون أمام جرعة متكاملة من الفشل، أمنيًا ومؤسساتيًا وحقوقيًا وحتى سياسيًا، وتُبقي الباب مشرعًا أمام استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وديمومة الإفلات من العقاب، وتقوّض السيادة، وترفع مصالح الجماعة فوق مصالح الدولة.
لقد بنى نظام الأسدين الدولة الثكنة، أي عسكرة المجتمع، وكذلك التطبيع مع مقولة “من يحرر يقرر” هو ديمومة لعلوية العسكرة وأحكامها الفوقية الإخضاعية في بناء المؤسسات والانتقال السياسي وبناء الدولة، ودون فهم شواغل غالبية السوريين والسوريات في تحقيق القطيعة مع الاستبداد بكل أشكاله، وبناء نموذج أمني يُطمئنهم لا يخيفهم، يقوم على حماية الإنسان وحقوقه، وتعزيز الأمن الإنساني، ويعتمد في بناء القطاع الأمني، وبضمنه مؤسسة الجيش، على قواعد أرستها الدول الحديثة، قائمة على حياده، ومهنيته، وفحص أهلية المنضوين فيه، والرقابة المدنية عليه، أي رقابة المؤسسات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني.
لا شك أن بناء الجيش والانتقال من العقلية الفصائلية وطبيعتها الغنائمية وصراعاتها على الموارد والنفوذ، وتخلصها من الريعية والولاءات الجهوية والطائفية هي عملية صعبة وطويلة الأمد، ويجب أن تتسم بملكية وطنية وإجراء مشاورات وطنية مع مراكز أبحاث مهتمة بإصلاح القطاع الأمني وخبراء الأمن، نساء ورجالًا، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتعددة المتعلقة في بناء القطاع الأمني في دول أنهكها النزاع وترهلت مؤسساتها، وأن يكون البناء جزءًا من استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية التحولية، والتي تقوم ركائزها على المحاسبة ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات والتشريعات، من أجل إعادة الثقة في المؤسسات ومنع تكرار الجرائم والانتهاكات، وإحداث قطيعة مع ثقافة الإفلات من العقاب.
ختامًا، إن بناء الجيش المحايد، وخضوعه للمساءلة الديمقراطية، وضمان ولائه للحكومات المنتخبة ديمقراطيًا، وعدم تدخله في الخلافات السياسية بين المجتمع والحكومة، وبنتائج الانتخابات، وعدم انحيازه إلى دكتاتور أو حزب سياسي، وضمان ألا يقود انقلابًا أو يدعم انقلابًا، لا يمكن أن يتم دون قيود دستورية ومؤسساتية على دور الجيش، وقضاء مستقل، وفصل للسلطات، وثقافة مؤسساتية ومجتمعية تحترم حقوق الإنسان، وإلا فيخسر الجيش شرعيته إذا وجه سلاحه ضد الشعب أو أي فئة منه، وإذا انحاز لمصالح فئوية وتم بناؤه على اللون الواحد.
عنب بلدي
———————————
========================
الموقف الأميركي اتجاه سوريا، مسالة رفع العقوبات، الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية على الحكومة السورية تحديث 19 نيسان 2025
لمتابعة هذا الملف التبع الرابط التالي
العقوبات الأميركية على سوريا الجديدة وسبل إلغائها
———————————
متى تُرفع العقوبات الغربية عن سوريا؟/ عمر كوش
21/4/2025
ما تزال العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية تقف حائلًا أمام تعافي سوريا الجديدة، وتمنع البدء بعمليات إعادة إعمار ما دمّره نظام الأسد البائد، حيث تضع كل من الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وألمانيا واليونان وقبرص، شروطًا عديدة من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتربط رفعها بالخطوات التي ستقوم بها الإدارة الجديدة، وذلك على الرغم من ترحيبها ببعض الخطوات التي قامت بها السلطات الجديدة، وخاصة الحكومة الانتقالية، التي وصفتها واشنطن بحكومة تكنوقراط، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرحه السوريون، هو: متى ترفع العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم؟
الواقع هو أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قامت ببعض الإجراءات، تضمنت إصدار إعفاءات مؤقتة لمدة ستة أشهر من العقوبات، وطالت قطاعات الطاقة والمياه والحوالات الشخصية، فيما تضمنت الإعفاءات التي قررها الاتحاد الأوروبي إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
إضافة إلى إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي.
لكن كل هذه الإجراءات ليست كافية للخروج من الوضع الاقتصادي الكارثي في سوريا، خاصة أن الإعفاءات الأوروبية غير فعالة في ظل استمرار العقوبات الأميركية.
الشروط الأميركية
تتمحور الشروط الأميركية المعلنة حول ضرورة تمثيل الأقليات، ومحاربة الإرهاب، وتدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيماوية، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العسكرية العليا، والمساعدة في مساعي العثور على الصحفي الأميركي المفقود في سوريا أوستن تايس.
وتتقاطع مع الشروط الأوروبية، وتضيف إليها “وقف الانتهاكات”، التي جرت في الساحل السوري، ومحاسبة المتورطين فيها وغيرها.
وقد سبق أن سملّت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، ناتاشا فرانشيسكي، قائمة الشروط الأميركية إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال اجتماع مباشر عُقد على هامش مؤتمر للمانحين بشأن سوريا في بروكسل يوم 18 مارس/ آذار الماضي.
مؤخرًا، قدمت الحكومة السورية للإدارة الأميركية ردّها الرسمي على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن كمتطلبات أساسية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
ويعكس عدم تلكؤ الحكومة السورية الجديدة في الرد عليها نوعًا من الالتزام ببعض الشروط، مع إبداء المرونة والاستعداد للعمل على بعضها الآخر، لكن الأمر ليس سهلًا، لأن انفتاح العلاقات بين واشنطن ودمشق، يعني طي صفحات سوداء وشائكة، بدأت منذ عام 1979، عندما فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا، وأدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ثم أضافت عقوبات كثيرة بعد قيام الثورة السورية عام 2011، أبرزها عقوبات بموجب “قانون قيصر”.
إضافة إلى أن الوضع في سوريا معقد ومتشابك مع الأوضاع الإقليمية والدولية، يتقاطع معها أحيانًا، ويتعارض معها في أحيان أخرى، وخاصة بخصوص التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ إسقاط نظام الأسد البائد، ومحاولة إسرائيل تحويل سوريا إلى ساحة منافسة مع الأتراك، فضلًا عن العلاقة القوية ما بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، حيث تريد إدارة ترامب أن توقع الحكومة الجديدة اتفاق سلام مع إسرائيل، يحفظ أمن إسرائيل وتفوقها عسكريًا، دون أن تسترجع سوريا أراضيها المحتلة وخاصة الجولان المحتل.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الشروط الأميركية تعدّ متطلبات داخلية، خاصة فيما يتعلق بالحكم الشامل، وتمثيل مختلف مكونات الشعب السوري، والتخلص مما تبقى من الأسلحة الكيماوية، حيث أبدت الحكومة السورية تعاونًا كاملًا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقد أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في أكثر من مناسبة التزام سوريا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد، وتحقيق العدالة للضحايا، والامتثال للقانون الدولي.
كما أن السلطات الجديدة ملتزمة بمكافحة الإرهاب، وثمة عداء قديم وقتال تاريخي بين فصائل غرفة “ردع العدوان”، وفي مقدمتها “هيئة تحرير الشام” وتنظيم الدولة الإسلامية.
وسبق أن شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة، أفضت مؤخرًا إلى إحباط محاولة تنظيم الدولة تفجير مقام السيدة زينب الواقع في جنوبي دمشق.
إضافة إلى أن سوريا وقعت في التاسع من مارس/ آذار الماضي اتفاقًا خلال اجتماع عمان مع دول الجوار: (الأردن، والعراق، ولبنان، وتركيا)، يدين الإرهاب بكافة أشكاله، ويقضي بمحاربته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، وبتشكيل مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم الدولة، بغية القضاء عليه، والتعامل مع سجون عناصره.
تفترق الولايات المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تضع الوجود العسكري الروسي في سوريا ضمن الشروط الأميركية المعلنة، فيما طالب أكثر من مسؤول أوروبي بذلك، ولعل الأمر يعود إلى العلاقة المميزة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.
لكن هذه العلاقة لا تمنع وجود جدل بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا. ولعل زوال التغلغل الإيراني في سوريا كان أكبر مكسب قدمته سوريا الجديدة للولايات المتحدة، دون أن تقدم أي تكلفة تذكر.
بصرف النظر عن كل ذلك، فإن سياسات إدارة الرئيس ترامب حيال السلطة الجديدة في سوريا تحظى باهتمام سوري كبير، حيث تأمل في أن يشكل الرد السوري على الشروط الأميركية بداية لحوار بين واشنطن ودمشق يمهد لرفع العقوبات أو على الأقل تخفيفها.
كما أنها تترقب ما ستثمر عنه زيارة وفد سوري إلى واشنطن، يترأسه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ويضم وزيرَي المالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، من أجل حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بين 15 و20 أبريل /نيسان المقبل.
إذ على الرغم من أن الزيارة تحمل صبغة اقتصادية، فإن الوفد سيحاول عقد لقاءات جانبية مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، ومع عدد من النواب في الكونغرس، حيث من المتوقع أن تشهد تلك اللقاءات بحث قضايا تتعلق بالعقوبات، وعمليات إعادة الإعمار، والنظر في العلاقات بين دمشق وواشنطن.
وبالتالي فإنه على الرغم من عدم اعتراف إدارة ترامب الرسمي بالحكومة السورية الجديدة، فإن زيارة الوفد السوري، والمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولين في واشنطن، تشي بإمكانية حدوث تحوّل تدريجي في تقييم الولايات المتحدة للسلطة السورية الجديدة.
لذلك يعوّل السوريون على أن تشكّل الزيارة فرصة من أجل عرض رؤية الحكومة السورية بشأن إعادة الإعمار وبناء الدولة، ومحاولة كسب دعم دولي أوسع.
والأهم هو أن تلجأ إدارة ترامب إلى القيام بتخفيف جزئي وانتقائي للعقوبات في حال تقييمها الإيجابي لرد لحكومة السورية، ومدى التزامها بالخطوات المطلوبة، الأمر الذي يرافقه إصدار إعفاءات إضافية، أو دعم دولي للمشاريع الإنسانية والبنية التحتية.
غير أن رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا ما يزال يواجه عقبات داخل الإدارة الأميركية والكونغرس، وذلك بسبب انقسام مواقف مسؤولي الإدارة الأميركية حيال سوريا، ما بين شخصيات في وزارة الخارجية الأميركية، تدعو إلى ضرورة منع تحول سوريا إلى الفوضى والتناثر، وتطالب بأن تتعامل إدارة ترامب بواقعية مع الحكومة السورية الجديدة، ومنحها فرصة لإثبات تغيرها، وشخصيات أمنية متشددة في مجلس الأمن القومي والاستخبارات، تحذر من التعامل مع السلطة الجديدة، وتخشى من التنظيمات المتطرفة، وتشكك في إمكانية تحوّل سوريا إلى حليف موثوق.
وفي هذا السياق، يلعب اللوبي الإسرائيلي، وحكومة بنيامين نتنياهو دورًا ممانعًا لأي تقارب أميركي مع السلطة السورية الجديدة، لذلك يعتبر كل من الرد السوري على الشروط الأميركية والزيارة المرتقبة للوفد السوري إلى واشنطن بمثابة اختبار حاسم بالنسبة إلى الحكومة السورية الجديدة.
أخيرًا، يبقى أن من المهم رفع العقوبات الغربية، وخاصة الأميركية، المفروضة على سوريا، لكن الأهم هو أن الحكومة السورية الجديدة ينبغي ألا تتعامل معها وكأن كل شيء متوقف على إزالتها أو تخفيفها، وأن تَبذل مزيدًا من العمل في الداخل السوري، وبشكل يدعم توسيع الحريات، ويؤسس لدولة القانون والعدالة، وتقوية كل القوى الفاعلة فيه على كافة المستويات؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والاستفادة من كل إمكانات السوريين، وتفعيل المؤسسات وتمكينها من العودة للعمل بكامل طاقتها، والاعتماد على أصحاب الخبرات والطاقات السورية، الذين هربوا من مقبرة نظام الأسد البائد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وباحث سوري
الجزيرة
———————————–
المطالب الأميركية الثمانية من سوريا… ماهي، وكيف ردت دمشق عليها؟/ براهيم حميدي
نحو سياسة أميركية متكاملة عن سوريا
آخر تحديث 19 أبريل 2025
تُظهر ثلاث وثائق، أميركية وسورية وأممية اطلعت “المجلة” على مضمونها، الاتجاهات المحتملة للعلاقات بين دمشق وكل من واشنطن والأمم المتحدة.
وإذ تتضمن الوثيقة الأميركية ثمانية مطالب للبدء في تخفيف العقوبات وإعطاء رخصة لمدة سنتين، بينها مطالب وجدت دمشق صعوبة في قبولها، يتعلق أحدها بـ”إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الفصائل الفلسطينية والأنشطة السياسية”، والثاني بالموافقة على قيام أميركا باستهداف أي شخص تعتبره واشنطن تهديدا لأمنها، مع تصنيف كل من “الحرس الثوري” الإيراني و “حزب الله” اللبناني تنظيما إرهابيا، فإن رد دمشق الخطي على رسالة تسلمها وزير الخارجية أسعد الشيباني من نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ناتاشا فرانشيسكي، في بروكسل منتصف مارس/آذار الماضي، أشار إلى تحقيق تقدم في ملفات عدة بينها التخلص من السلاح الكيماوي التابع للنظام السوري السابق، ومحاربة “داعش” والإرهاب، وتشكيل الجيش.
أما الوثيقة الأممية التي بادر بها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة نائب رئيس وزراء سوريا السابق عبدالله الدردري، فإنها تتناول اقتراحا بموافقة دمشق على قيام “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة” بالإشراف على إنفاق أموال “الدولة السورية” المجمدة في أوروبا، وتقدر بنصف مليار دولار أميركي، على مشاريع في سوريا بعيدا عن العقوبات الأميركية.
الإفراج عن 500 مليون دولار مجمدة في أوروبا
يجري العمل بكثافة على وضع اللمسات الأخيرة على زيارة وفد يضم وزير المال محمد يسير برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية، إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمشاركة في طاولة مستديرة عن سوريا نهاية الأسبوع. قبل قيام وزير الخارجية أسعد الشيباني بزيارة نيويورك نهاية الأسبوع لحضور اجتماعات وزارية في مجلس الأمن ورفع علم سوريا.
وأفادت “رويترز” بأن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.وأضافت أن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.
وبعد سداد المبلغ، يمكن للبنك الدولي دعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، وسط توقعات بتقديم 300 مليون دولار لقطاع الكهرباء والبنية التحتية.
وقد اطلعت “المجلة” على وثيقة أعدها “البرنامج الإنمائي”، تفيد بأن ملف الأصول والأموال السورية المجمدة في المصارف الأوروبية يُعد من أعقد التحديات المالية في المشهد الانتقالي.
ومنذ فرض عقوبات أوروبية على النظام السابق بعد 2011، قالت وثيقة “البرنامج الإنمائي” إن هناك أصولا تابعة للدولة السورية وشخصياتها في الخارج، تقدر بحوالي نصف مليار دولار (500 مليون دولار أميركي)، ظلت مجمدة بموجب العقوبات الدولية. وتقترح الوثيقة أن “يلعب البرنامج” دور الوسيط والميسر بين الجهات السورية والدولية لحل هذه المعضلة، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.
وبين المقترحات “إنشاء آلية مؤسسية عبر المنظومة الأممية، أي “البرنامج الإنمائي”، بهدف استثمار هذه الأصول المجمدة في تمويل مشاريع تنموية وإعادة إعمار في سوريا بدلا من الإفراج المباشر عنها لحساب الدولة السورية”، ذلك لأن الدول المانحة تبدي “حذرا من تسليم الأموال المجمدة للسلطات السورية مباشرة بسبب تعقيدات قانونية وسياسية تتعلق بشرعية هذه الأصول وإمكانية تعرضها لسوء الاستخدام”.
وقال دبلوماسي غربي، إن “الأموال ملك الدولة السورية ويمكن التصرف فيها دون وسيط، مما سيزيد من الأعباء المالية في صرفها وتمويل المشاريع في البلاد”.
وفي عضون ذلك، وضعت الأمم المتحدة السيناريوهات القانونية والمؤسسية اللازمة لأي تحرك في هذا الملف. ويشمل ذلك تقديم المشورة لمصرف سوريا المركزي، الذي تسلمه قبل أيام الخبير عبدالقادر حصرية، حول السبل القانونية للمطالبة بهذه الأصول أو الاستفادة منها وفق القوانين الدولية، وضمان الشفافية والتوافق مع قرارات العقوبات.
العلم السوري يرفع في نيويورك
يتوجه وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى نيويورك آخر الأسبوع، ويتضمن برنامجه رفع العلم السوري في مقرات الأمم المتحدة وحضور جلسات لمجلس الأمن سواء لدى إلقاء المبعوث الأممي غير بيدرسون إفادته في 25 أبريل/نيسان أو لدى جلسة عن حال الشرق الأوسط في 29 أبريل. ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية بينهم الفرنسي جان نويل باروفي هذه الاجتماعات.
تأتي هذه الزيارة بعد أن خفضت الخارجية الأميركية مستوى تأشيرات الوفد السوري في نيويورك، ليصبح ممثلا لحكومة “لا تعترف بها الحكومة الأميركية”، وهو إجراء لم تقم به واشنطن خلال مرحلة نظام الأسد في العقد الأخير.
اتجاهان في أميركا
بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول، فتحت دول عربية وأوروبية علاقات مع الحكم الجديد والرئيس أحمد الشرع، فيما اتبعت واشنطن أسلوبا حذرا، إذ التقت مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، أحمد الشرع في دمشق، كما ألغت واشنطن الجائزة المالية التي كانت مخصصة لمعلومات عنه وقيمتها عشرة ملايين دولار.
في موازاة ذلك، حصل تعاون أمني وتبادل معلومات في مجال مكافحة الإرهاب، إذ زودت واشنطن دمشق بمعلومات أدت إلى إحباط ثمانية عمليات إرهابية على الأقل. كما بعث الرئيس الشرع برقية تهنئة إلى ترمب لدى فوزه بالرئاسة. وقال الشرع في رسالة باللغة الإنكليزية: “نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة”. وتابع: “نتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين بناء على الحوار والتفاهم”، وأنه في عهد الإدارة الأميركية الجديدة “ستستفيد الولايات المتحدة وسوريا من الفرصة لإقامة شراكة تعكس تطلعات البلدين”.
لكن الإدارة الأميركية تغيرت، واتبعت نهجا أكثر حذرا، وسط نصائح من دول عربية عدة لواشنطن باتباع نهج أكثر انفتاحا مع سوريا. ويجري العمل داخليا لصوغ سياسة أميركية متكاملة عن سوريا بمشاركة جميع المؤسسات الأميركية. ومن المتوقع أن يتسلم جول روبرن، الموقع الأبرز في الخارجية بالإشراف على الملف السوري. واستقبل الشرع عضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ تسلم الحكم الجديد. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني ميلز، “حيث جرى بحث الوضعين الأمني والاقتصادي في سوريا، وآفاق بناء شراكة استراتيجية بين دمشق وواشنطن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”. كما تناول اللقاء “التهديدات المشتركة التي تواجه البلدين والمنطقة، بما فيها الميليشيات العابرة للحدود وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة” و “أثر العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، حيث أكد الجانب السوري على ضرورة رفع هذه الإجراءات غير القانونية كخطوة أساسية نحو بناء الثقة والانخراط في مسارات تعاون بناء”، بحسب بيان رسمي.
وحسب قول مسؤولين لـ”المجلة”، هناك اتجاهان في الادارة الأميركية: الأول، يمثله مسؤولون في مجلس الأمن القومي ومديرة المخابرات تولسي غابارد، ومدير قسم مكافحة الإرهاب سباستيان كورغا، وهما يرفضان أي انخراط مع الحكم السوري الجديد وينظران إلى شخصيات فيه من باب قرار مجلس الأمن بتصنيف “هيئة تحرير الشام” ومسؤولين فيها وتصنيف واشنطن لهم في قائمة التنظيمات الإرهابية. الثاني، يمثله وزير الخارجية ماركو روبيو ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، الذي يقوم على الانخراط المشروط، مقدرين الدور الكبير للنظام السوري الجديد بإضعاف إيران استراتيجيا في الشرق الأوسط.
ثمانية مطالب أميركية
بناء على ذلك، صاغ ممثلو الإدارة السابقة والمقبلة وثيقة مطالب قدمتها الدبلوماسية فرانشيسكا إلى الشيباني في بروكسل شهر مارس/آذار الماضي، وتضمنت ثمانية مطالب لـ”بناء الثقة” وخطوات مقابلة يمكن أن تقوم بها واشنطن. وحسب الوثيقة التي اطلعت “المجلة” على مضمونها، فإنها تتضمن: تشكيل جيش مهني وعدم وضع المقاتلين الأجانب في مناصب قيادية حساسة، والوصول إلى جميع منشآت السلاح الكيماوي والبرنامج الخاص به، وتشكيل لجنة للمفقودين الأميركيين بينهم الصحافي آستون تايس، وتسلم عائلات “الدواعش” من معسكر الهول الواقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي سوريا، والتزام علني بالتعاون مع التحالف الدولي في محاربة “داعش”، والسماح لأميركا بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ضد أي شخص تعتبره واشنطن تهديدا للأمن القومي، و”إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الميليشيات الفلسطينية والأنشطة السياسية” في سوريا، وترحيل أعضائها “لتهدئة المخاوف الإسرائيلية”، ومنع تموضع إيران وتصنيف كل من “الحرس الثوري” و “حزب الله” تنظيما إرهابيا.
ولم تتضمن القائمة مطلبا يتعلق بتشكيل “حكومة جامعة” أو أمورا ملموسة تتعلق بالعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والإصلاح الدستوري والعملية السياسية، لكنها ذكرت في إطار الإضافات وليس البنود التنفيذية. ووعدت الوثيقة في المقابل بتخفيف العقوبات وتمديدها الإعفاءات لدى انتهاء مدة الستة أشهر في يوليو/تموز المقبل بعد إعلان قرار الإعفاءات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي. وهناك من وعد بأنه في حال تحقق التقدم في المطالب، يمكن أن يصدر الرئيس دونالد ترمب قرارا تنفيذيا بتجميد “قانون قيصر” لفترة معينة، وهو القانون الذي يشكل العقبة الأساسية أمام تحرك الاقتصاد السوري وتقديم مساعدات خارجية.
رد دمشق… تعاون وتحفظ
قراءة دمشق الأولية للورقة/الرسالة، كانت مخيبة للآمال، خصوصا أنها تضمنت بنودا تخص السيادة السورية، ووجدت صعوبة في “هضم” هذه المطالب رغم نصائح جاءت لدمشق من أطراف عدة، خصوصا ما يتعلق بحظر “النشاط السياسي” للفصائل و”ملاحقة شخصيات” وحرية تحرك قوات التحالف داخل الأراضي السورية.
وبعثت الخارجية السورية نهاية الأسبوع الماضي، ردا خطيا تتضمن خطواتها وتحفظاتها على بعض المطالب إلى واشنطن التي عكفت على دراستها. ويعتقد مسؤولون غربيون أن دمشق حققت سلفا الكثير من الخطوات الخاصة بالسلاح الكيماوي.
وكان الشرع قد استقبل وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية برئاسة فرناندو أرياس المدير العام للمنظمة في فبراير/شباط الماضي، وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها لدمشق منذ الإطاحة بالأسدالمتهم باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع.
وقال أرياس إن اجتماعات وفد المنظمة في دمشق تمهد لغلق ملف الأسلحة الكيماوية السوري نهائيا، معتبرا أن زيارته لدمشق تشكل فرصة “لانطلاقة جديدة” وطي صفحة هذا الملف بعد تأزم استمر سنوات في عهد الأسد. وكشفت “حظر الأسلحة الكيماوية” عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد على 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة في سوريا، اكتُشفت عقب انهيار حكم الأسد.
كما اتخذت دمشق خطوات بينها منع نشاطات الفصائل الفلسطينية المسلحة ومحاربة “داعش” وتحسين علاقتها مع “قوات سوريا الديمقراطية” حليفة واشنطن.
وكان الشرع قد وقع اتفاقا مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي الذي جاء مرتين إلى دمشق على متن مروحية أميركية. واتخذت خطوات عدة لتنفيذ ورقة مبادئ وقعت في دمشق يوم 10 مارس الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تعتزم خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريبا في الأشهر المقبلة.وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجيش الأميركي بدأ في سحب مئات الجنود من شمال سوريا، ويستعد لإغلاق 3 من أصل 8 قواعد عسكرية في المنطقة.
وفي موازاة تنفيذ اتفاق الشرع مع عبدي، هناك وقف إطلاق نار بين “قوات سوريا الديمقراطية” وتركيا في شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع حديث واشنطن عن خفض قواتها.
المجلة
——————————————
سوريا ميدان النفوذ.. انكفاء واشنطن وتمدد أنقرة وقلق تل أبيب/ عبد الله مكسور
2025.04.21
“الفراغ في السياسة كما في الطبيعة، لا يلبث أن يُملأ، وغالبًا ما تملأه القوى الأكثر استعدادًا لا الأكثر شرعية.”، أتذكر هذا القول لنيكولا ميكافيللي وأمامي ترتسم الجغرافيا السورية بحدود سايكس بيكو الاستعمارية التي نعرفها، وفيها وعليها ترنُّ صدى الخُطى المتسارعة للقوى الإقليمية والدولية، لتتشكّل خارطة جديدة، تُرسم لا بالحدود بل بالقواعد العسكرية، ولا بالحكومات بل بمراكز السيطرة. سوريا التي مرَّت بسنوات عجاف تحت حكم نظام الأسد، تحوّلت بعد 8 ديسمبر 2024 إلى قلب معركة النفوذ- بشكل أو بآخر- بين تركيا وإسرائيل، في ظل انكفاء أميركي متدرّج، وغياب سوري موجع عن طاولة القرار.
سوريا اليوم في ظرفها الحالي ليست “دولة” بالمعنى التقليدي، بل ميدان، لا تُدار فيه النزاعات فحسب، بل تُختبر فيه الرؤى الكبرى لإعادة توزيع السلطة في الشرق الأوسط. واللافت أن الانسحاب الأميركي المرتقب ليس مجرد خطوة عسكرية، بل إعلان ضمني بانتهاء مرحلة وبدء أخرى، قوامها التفاهم التركي–الإسرائيلي الخفي، والمراهنة الروسية الباردة، ومحاولات سورية محلية لبناء دولة من ركام النظام القديم وعلى أنقاضه.
منذ سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر 2024، بدأت توازنات ما بعد الحرب تنقلب على رأسها وتظهر بشكل أكثر وضوحا. القوى التي ظلت لعقد كامل—تراقب، تُفاوض، تُناور—وجدت نفسها فجأة أمام فرصة تاريخية لتوسيع نفوذها وفرض رؤيتها للمنطقة. تركيا، التي لطالما نظرت إلى الشمال السوري باعتباره عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي، اندفعت بثقة نحو ما بعد خطوط الفصل، مستندةً إلى تفويض سياسي غير معلن جرى في كواليس باكو بين أنقرة وتل أبيب، وتحت رعاية موسكو غير المعلنة وغير الحاضرة رسمياً في أذربيجان.
في المقابل، لم تُخفِ إسرائيل قلقها، لكنها لم تواجهه بالصوت، بل بالتفاهم. فمع وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مجددًا، عاد منطق “الصفقات الكبرى” ليحكم السياسة الخارجية الأميركية، لا منطق “الالتزام طويل الأمد”. ترمب، الذي لا يرى في سوريا إلا ساحة عبء، اختار أن يُفرغها من الجنود لا من النفوذ، وأن يُسلّم أوراقها لحلفاء موثوقين، قادرين على إدارة مصالح واشنطن بأدوات إقليمية. وهكذا، وُلدت تفاهمات أذربيجان، بحسب ما تسرّب منها، مساحة عازلة لأنقرة، ومجال مراقبة آمن لتل أبيب، في مقابل انسحاب تكتيكي أميركي يُبقي اليد على الزناد حتى من دون أن يظهر.
لكن هذه الترتيبات لا تلغي الحقيقة المرّة: أن سوريا باتت اليوم مسرحًا لفائض القوة التركية، وهاجسًا أمنيًا دائمًا لتل أبيب، وحقل اختبار لمدى قدرة الروس على ملء الفراغ الأميركي من دون التورط في مستنقع جديد. فأنقرة تتحرك بثقة القوة الناعمة والصلبة معًا، من التعليم إلى الإدارة المحلية، ومن النفوذ العسكري إلى الشبكات الاقتصادية، في حين إسرائيل تراقب وتتدخل حين يلزم وفقا لمنطق اللزوم لديها، وتعيد تموضعها البري والجوي والاستخباراتي بما يتناسب مع ديناميكيات مرحلة ما بعد الأسد.
أما واشنطن، فرغم انسحابها المعلن، لا تزال تمسك بالخيوط الطويلة: تدفقات السلاح، نظم الرقابة الجوية، المنصات النفطية، وقنوات القرار الكردي. فهي تُغادر ولكن لا ترحل، وتسمح للآخرين بلعب الدور، لكنها تبقى المرجع الأعلى لمعادلات الأمن. هكذا، يتشكّل ميدان جديد في سوريا، ميدان بلا سيادة، بلا مركز، حيث تتزاحم الوصايات وتتماهى التحالفات. مشهدٌ يشبه رقعة شطرنج، لكنّ اللاعبين ليسوا متقابلين، بل متداخلين، وكلٌ منهم يمسك قطعةً من اللعبة، يحرّكها وفق منطقٍ لا يُقال أو يُعلَن، بل يُفهم من خريطة النفوذ. وكأننا ضمن مشهد في رواية “لاعب الشطرنج” لستيفان زفايغ على متن سفينة تمخر البحر في أميركا اللاتينية.
واشنطن تُغادر… لكنها لا ترحل
في الأدبيات العسكرية الأميركية تتردد الجملة التالية بشكل غير معلن: “الانسحاب لا يعني الرحيل، بل إعادة التموضع خلف الستار.”، فالحديث عن انسحاب أميركي من سوريا في أي مرحلة زمنية لم يكن يومًا حديث نهاية، بل إعلان عن تحول في نمط السيطرة. فواشنطن، التي دخلت الأراضي السورية في خريف 2014 تحت لافتة “التحالف الدولي لمحاربة داعش”، لم تكن تسعى إلى احتلال أرض، بل إلى احتلال قرار. والفرق بين الإثنين جوهري: فالأرض يمكن مغادرتها، أما القرار فالبقاء فيه يتخذ أشكالًا أكثر نعومةً وتأثيرًا. وعند التدقيق في طبيعة التمركز الأميركي في سوريا خلال العقد الأخير – رغم شح المعلومات عن عدد وحقيقة القواعد الأميركية في الأراضي السورية-، يتضح أنه كان أقرب إلى “الاحتلال الذكي” منه إلى الاحتلال التقليدي. ففي الشمال الشرقي، من رميلان إلى الحسكة، ومن الشدادي إلى التنف، أقامت الولايات المتحدة منظومة من القواعد العسكرية التي لا تتمدد أفقيًا بل عموديًا: تحت الأرض وفي السماء، ضمن قواعد قواعد اشتباك دقيقة، مفصّلة، ومتغيرة بحسب اللحظة السياسية والإقليمية. وبخلاف الرواية الرسمية التي أُطلقت عام 2014، بتركيز على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، فإن القواعد الأميركية في سوريا أُقيمت لأسباب استراتيجية تتجاوز ذلك التهديد العابر. فقد أدركت واشنطن منذ سنوات الفوضى الأولى أن سوريا ليست مجرد ساحة حرب، بل معبر ومفترق وملتقى. هي نقطة التقاء بين خطوط إمداد إيران إلى حزب الله، وبين الحدود الحساسة لإسرائيل، وبين الجغرافيا العميقة التي تمتد إلى الأنبار العراقية ومايليها حيث يتعاظم النفوذ الإيراني منذ عام 2003.
لهذا، كانت قاعدة “التنف” نموذجًا صارخًا لجوهر العقيدة العسكرية الأميركية الجديدة: قواعد صغيرة، مرنة، بلا مظاهر كبيرة، لكن ذات فعالية استخباراتية عالية، ومتموضعة على نقاط الخطر. التنف، الواقعة على مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، لم تكن قاعدة لمحاربة تنظيم الدولة فقط، بل لمراقبة التحركات الإيرانية بدقة، ولمنع الربط البري بين طهران وبيروت. كانت عين واشنطن على طريق الحرير الإيراني الجديد، وليس فقط على مقاتلي التنظيم المهزوم. وقد ساقتني الأقدار إلى لقاء مع ضابط خدم في التنف وقد أسرَّ لي عن استخدام القاعدة في مرحلة ما كسجن مؤقت لعناصر من تنظيم داعش قبل نقلهم إلى وجهات غير معلومة.
قواعد الاشتباك: جيوش تحت الوصاية
منذ اللحظة الأولى، لم تكتفِ واشنطن بتثبيت مواقع عسكرية، بل أسّست لشكل غير معلن من قواعد الاشتباك بين جميع القوى الفاعلة في الميدان السوري. فعبر دعمها لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، تمكنت من خلق جيش محلي بالوكالة، تديره بأدوات التمويل والتدريب، وتتحكم عبره بمساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا، وهذا ليس خافياً على أحد. لكن الدعم الأميركي لم يكن مطلقًا. بل جاء مشروطًا بخضوع هذا “الجيش الوكيل” لشبكة من التعليمات، تبدأ بحدود التحرك، ولا تنتهي بقوائم الأهداف. كانت قسد تعرف أن إطلاق رصاصة واحدة خارج التنسيق مع الأميركيين قد يُفقدها الدعم، وأن التحرك تجاه الحدود التركية أو الاقتراب من مناطق جيش نظام الأسد قد يُدخلها في عاصفة مع واشنطن.
ولعل أخطر ما كرّسته هذه العلاقة هو تعويم مفهوم “السيادة المنقوصة” في مناطق قسد، حيث بات القرار المحلي مشروطًا بإرادة القاعدة العسكرية القريبة، وتحديدًا تلك المنتشرة في رميلان والمالكية وشرقي دير الزور. وضمن منطق ضبط إيقاع الحرب والسلام لم تكن القواعد الأميركية معزولة، بل نسجت شبكة من العلاقات النشطة، إن لم نقل المُهيمنة، مع الفاعلين الإقليميين. مع تركيا، حافظت واشنطن على توازن هش، من خلال إرسال تطمينات استخباراتية، ومحاولة ضبط اندفاعات أنقرة نحو العمق السوري.
في حين أخذت هذه القواعد مع إسرائيل، شكلاً آخر فقد كانت ركيزة لتبادل المعلومات في إطار ما يمكن أن يتم تعريفه بـ”الاحتواء الذكي لإيران”. إذ لطالما مثّلت القواعد الأميركية في شرقي سوريا نقاط إنذار مبكر لأي تحرك إيراني قد يستهدف الجولان أو غيره، وهو ما اعتمدت عليه تل أبيب في كثير من عملياتها الجوية التي نفّذتها داخل سوريا خلال العقد الأخير.
أما مع روسيا، فكانت العلاقة أكثر تعقيدًا. فرغم العداء الظاهر، جرت تفاهمات تحت الطاولة يمكن تلمُّسها من اتفاق “عدم التصادم الجوي”، الذي قنن حركة الطائرات في سماء سوريا، وفصل مناطق السيطرة الأميركية عن تلك الروسية. هذه التفاهمات أوجدت نوعًا من “الهدنة الدائمة” بين القوتين، لكنها في الوقت نفسه ثبّتت حالة الانقسام الجغرافي لسوريا.
السؤال الجوهري الآن لماذا تُعلن واشنطن اليوم نيتها الرحيل؟ وهل هو فعلاً انسحاب، أم إعادة توزيع للقوة؟ المتابع يدرك أن الانسحاب لا يأتي من فراغ، بل من قراءة أميركية لتغير قواعد اللعبة. فسقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 أنهى توازنًا هشًا استمر لأكثر من عقد، وفتح الباب أمام فاعلين جدد – لا سيما تركيا – لملء الفراغ. كما أن تراجع التهديد الإيراني المباشر في الشرق قلّص مبررات البقاء العسكري الأميركي. إلى ذلك، هناك بُعد داخلي أميركي لا يُستهان به، وهذا يتمثل بالشارع الأميركي الذي لم يعد يتحمل وجود قواته في مناطق بلا أفق سياسي واضح، والنخبة السياسية التي ترى في الانسحاب “استثمارًا مقلوبًا” يقوم على الإنفاق المتزايد مقابل المكاسب السياسية المحدودة.
لكن هل ترحل واشنطن فعلاً؟ هنا يكمن جوهر المعادلة. الولايات المتحدة قد تسحب جنودها، لكنها لن تسحب نفوذها. فالمعسكرات التي تركتها وراءها درّبت أجيالًا من القادة المحليين، وغرست ثقافة القرار المؤسسي وفق الرؤية الأميركية. كما أن البنى الاستخباراتية التي بُنيت خلال السنوات العشر الماضية قادرة على البقاء من دون علم ظاهر. لقد أتقنت واشنطن وفق ما تعلمناه عنها لعبة “الوجود الغائب”: لا قواعد كبرى، لا أعلام، لا بيانات نارية، بل أدوات تحكم عن بُعد. كما لو أنها تُعيد إنتاج استعمار القرن الحادي والعشرين بنسخته الناعمة: تقنيات، شبكات، وكلاء… من دون الحاجة لدبابات أو جندي تقليدي يقف في الشارع. وفي ظل هذا النمط الجديد، قد يكون انسحاب واشنطن من سوريا أكبر دليل على استمرارها فيها. ذلك أن القوة الحقيقية، كما قال ميشال فوكو، لا تُقاس بوجود السلاح، بل بقدرة من يملك السلاح على فرض صمته في اللحظة المناسبة.
تركيا: من بوابة الحدود إلى قلب البادية
دخلت تركيا إلى شمالي سوريا تحت شعار مكافحة الإرهاب. لكن اليوم، بعد ديسمبر 2024، دخلت إلى قلب البلاد، من تدمر إلى البادية إلى مطار حماة، تحت شعار “إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية”. هذه ليست عملية أمنية بالمعنى التقليدي، بل مشروع نفوذ، يمكن مقاربته مع ما فعله العثمانيون في نهاية القرن التاسع عشر حين أنشأوا “قائمقاميات أمنية” في أطراف المشرق لضمان السيطرة على المركزـ مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات والمعاني والدلالات. فما يتم الحديث عنه اليوم بأن تركيا لا تبني مجرد قواعد عسكرية، بل بنية تحتية لنفوذ يبدو أنه طويل الأمد: نقاط مراقبة تحوّلت إلى معسكرات، ومعسكرات باتت تضم مراكز تدريب، ومراكز التدريب أصبحت مختبرًا يسهم بشكل أو بآخر بآليات إنتاج جيش سوري جديد، هذه القواعد لا تقوم على حدود الاشتباك بل على فلسفة التموضع، فكل قاعدة يتم الإشارة للتحضير لها في تدمر أو في محيط السخنة أو شرقي حماة ليست موضع تمركز عسكري فحسب، بل نقطة تَمثّل سياسي وتَوسّع مؤسسي، من خلالها تُصدّر أنقرة نسختها من الدولة “المنضبطة” التي تريد في سوريا، بما تحمله من مركزية وشبكات خدمات. وهكذا يجب فهمها والتعامل معها.
يمكن التوقف هنا عند تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال منتدى أنطاليا في فبراير 2025، والتي كانت أشبه ببيان تأسيسي لمرحلة جديدة. حيث قال: “تركيا ليست قوة احتلال، بل قوة استقرار. نحن لا ندخل الفراغ، بل نملؤه بأدوات البناء”، وهو بذلك لا يعبّر عن تحوّل في خطاب أنقرة فقط، بل عن نقلة في العقيدة التركية نفسها تجاه سوريا، عقيدة جديدة تنتقل من الحماية إلى الشراكة، ومن الأمن إلى الإدارة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزّز هذا التوجّه في خطابٍ وُصف بأنه “تاريخي”، حين قال: “نقف إلى جانب سوريا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وسنُسهم في إعادة بناء مؤسساتها بما يخدم وحدة ترابها وكرامة شعبها.” لكن ما لم يُقال، وما يُفهم بين السطور، هو أن “سوريا” هنا لم تعد الدولة بل المساحة، ولم تعد العلاقة التي تحكمها أخوّة الجغرافيا ومنطق المهاجرين والأنصار بل ضرورات التمركز الاستراتيجي الذي دفع أردوغان للقول بأن من يسعى إلى تقسيم سوريا عليه أن يواجه تركيا ذاتها.
في العمق من كل هذا، تسعى تركيا إلى صياغة واقع جديد على الأرض، يتجاوز فكرة “المنطقة الآمنة” التقليدية إلى “المجال الآمن الموسّع” الذي يمتد من اعزاز والباب بريف حلب، إلى الرقة ودير الزور، وصولًا إلى تدمر وخطوط البادية. ففي المحصلة لا تخفي تركيا أنها تتطلع لأن تكون القوة المرجعية في “سوريا الجديدة”، مستندةً إلى مقاربة هجينة تجمع بين القوّة الخشنة والناعمة، وبين السيادة المفككة والشرعية المتفاوض عليها. هي تُنشئ قواعد، لكنها تتحدّث عن المدارس، وتُسيّر أرتالًا عسكرية نشاهد صورها لكنها تدشّن شبكات مياه وكهرباء، وتبني ما تصفه بـ”العمق الاستراتيجي الاجتماعي”، كما ورد في أحد تقارير مراكز الدراسات الأمنية التركية. وهكذا، تمضي تركيا في مشروعها: لا كمجرّد لاعب عسكري، بل كفاعل سياسي يعمل على إعادة صياغة المركز من الأطراف، وفرض إيقاع تركي في قلب بلاد الشام، بحجّة إعادة البناء، وبهدف إعادة التموضع. والمفارقة أن هذا “التموضع” لا يصطدم فقط بإسرائيل أو بواشنطن، بل حتى بما تبقّى من “الدولة السورية” ذاتها في المستقبل القريب.
إسرائيل.. الخوف من حليف الأمس
إسرائيل التي كانت تُجاهر علنًا بعدائها لإيران، بدأت تهمس بقلقها من تركيا. القواعد التركية المزمع إقامتها في حماة وتدمر تمثّل، وفق المعنى الذي تسرَّب عن وصف جنرال إسرائيلي في محادثات باكو، “خطرًا غير مباشر لكنه أكثر ذكاءً”. فتركيا تبني جيشًا سوريًا لا يمكن التنبؤ بمآلاته، وتزرع أعينًا إلكترونية – من الرادارات والطائرات المسيّرة – على بُعد لا يتجاوز 500 كم من الجولان المحتل. فالقلق الإسرائيلي من أنقرة لا يتأتى هنا فقط من هذه الزاوية، بل من كفاءة هذا الوجود. فتل أبيب ترى في أنقرة منافسًا أمنيًا من نوع جديد “منافس لا يُشهر سلاحه، لكنه ينسج خرائط الولاء بهدوء”. وما التفاهمات التي جرت في أذربيجان سوى محاولة لتقنين هذا القلق، عبر إقامة “آلية تفادي الصِدام”، شبيهة بتلك التي أُبرمت مع الروس عام 2015.
في تقديري أن إسرائيل تشعر بوجود تركيا أنها أمام قوة ذات طابع إمبراطوري ناعم تستند إلى العاطفة، هذه القوة لا تسعى إلى الاجتياح بل لإعادة تدوير الهويات. وهذا يُشكّل خطرًا بنيويًا على فلسفة الردع الإسرائيلي التي بُنيت منذ حرب أكتوبر 1973 على فكرة: “السيطرة من الجو، والتفتيت على الأرض. ووفق قراءات استراتيجية فإن” تركيا تُقوّض هذه المعادلة من خلال السعي إلى توحيد الأرض السورية جزئيًا، تحت مظلة مرجعية تركية سواء كانت حاضرة أم غير حاضرة، تحاكي تجربة الباكستان مع أفغانستان في الثمانينيات، أو إيران مع “محور المقاومة” خلال العقدين الماضيين.
ثمّة قلق أعمق يراود المؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل، وهو أن الحليف الأميركي الذي كان يتولى “تنظيم المسرح السوري” لصالح تل أبيب، قد تراجع إلى خلف الستار، مفسحًا المجال أمام لاعبين أكثر مرونة، وأكثر شراسة على المدى الطويل. هنا، يظهر “التهديد التركي” ليس في القوة النارية، بل في القدرة على البناء المتراكم، في الزمن. إسرائيل تجيد الاشتباك مع عدو واضح، وتَربكها خصومة بطيئة تتقدّم بالطبقات والمساحة الاجتماعية لا بالصواريخ. والأخطر من كل ذلك، هو أن تركيا لا تُرسل رسائل مباشرة، بل تعمل بصمت، وتراهن على أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون محكومًا بالعجز الاستراتيجي وضبط الولايات المتحدة، فإسرائيل لا تستطيع ضرب أو استهداف قواعد تركية معلنة في تدمر أو غيرها من دون المجازفة بتفجير العلاقة مع الناتو، ولا تقدر على منع إنشاء شبكات النفوذ التركية داخل سوريا، لأن هذه الشبكات لا تُبنى بالدبابات، بل بالمنظمات غير الحكومية، والمناهج، والتدريب، والمياه، وربما بالرعاية الأوروبية والأميركية نفسها. لهذا يفكِّر العقل الإسرائيلي دائماً بوصف التمدد التركي بأنه الخصم الذي لا يحمل لافتة. وهو توصيف دقيق يعكس مأزقًا فكريًا يحمل التناقض في الطرح داخل العقل الإسرائيلي، فهل أنقرة حليف في الإقليم ضد طهران؟ أم منافس سري على النفوذ في سوريا؟ وهل يمكن الوثوق بمن يمدّ لك اليد في البحر المتوسط ويرمي عينه على البادية السورية؟
أمام هذه الأرضية يأتي الانكفاء الأميركي بعد ديسمبر 2024، وعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهذا ما زاد من اضطراب البوصلة الإسرائيلية. فالإدارة الجديدة في واشنطن أكثر انشغالًا بالصين والرسوم الجمركية وحدود المكسيك واللاجئين وبإعادة ترتيب البيت الداخلي، وأقلّ حماسًا لاستمرار دعم الخرائط الأمنية في المشرق. ترمب، براغماتيًا، لا يرى في الوجود التركي خطرًا، ظهر هذا جلياً فيما تسرَّب عن المحادثة الهاتفية بين ترمب أردوغان، ترمب يقول لأردوغان لقد أخذت سوريا، لقد فعلتها، وبهذا المنطق الترمبي يجد الأميركي غطاءً وفرصة لتقليص كلفة التورط الأميركي. لكن تل أبيب لا تشارك البيت الأبيض هذا الاطمئنان، هي لا تقرأ التحالفات بمصطلحات الميزانيات المالية وفق حسابات ترمب، بل بمفردات الوجود والنفوذ والذاكرة التاريخية والسردية الصهيونية.
ولهذا، بدأت إسرائيل تتحرّك على مستويات جديدة: تعزيز التنسيق الأمني مع اليونان وقبرص، فتح خطوط تواصل غير معلنة مع بعض المناطق في جنوبي سوريا، وتكثيف مراقبة البادية بالأقمار الاصطناعية، وحتى وصل بها الحال إلى تقديم مقترحات لنشر “قوات رمزية” أممية في بعض مناطق التماس مع إعلانها انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974. كل ذلك في محاولة لتثبيت وزنها في معادلة تزداد تسيّبًا، وتبتعد أكثر فأكثر عن الترسيم القديم لما يُسمّى بـ”سوريا المفيدة لإسرائيل”.، فتل أبيب تخاف من أن تستيقظ ذات يوم، وتجد أن سوريا لم تَعُد ساحة فوضى بل ساحة نفوذ مركّز، تُديرها أنقرة بهدوء، وتُراقبها موسكو ببرود، وتنسحب منها واشنطن بصمت.
باكو: منصة التفاهمات الجديدة
في مكان يمكن وصفه بالساحة غير الرسمية للتفاهمات المعقدة، جلس مسؤولون أتراك وإسرائيليون في أذربيجان، وهذا اللقاء ليس مجرد حدث عابر في منطق الأحداث في سوريا، فما تسرَّب عن محادثات أو مفاوضات أو اجتماع باكو يعني رسم خرائط جديدة للنفوذ، حيث تتقاطع مصالح الدول التي قد تظهر علنًا على خلاف، ولكنها تتفق في الخفاء على خطوط الاشتباك، والحديث هنا عن الطيران ومسارات الدوريات، ونقاط التحرك التي تبقى غير معلنة. هذه ليست مجرد محادثات دبلوماسية تقليدية، بل محاولات لتشكيل معادلات جديدة للأمن والنفوذ في المنطقة. الآلية التي سُمّيت بـ “تفادي التصادم” لم تكن في جوهرها سوى مقدمة لتفاهمات أعمق بكثير، تتجاوز الإطار الظاهر لتدخل في مفاوضات غير مرئية حول “من يسيطر على ماذا”، وما هي التنازلات التي يتم قبولها في إطار لعبة السلطة الإقليمية. وكما غابت سوريا عن الاجتماعات المتعلقة بمستقبلها في أنطاليا غابت عن اجتماع باكو، حتى لم يصدر من الدولة السورية الجديدة أي موقف مهما كان مستواه تجاه اللقاء والتفاهمات. لقد غابت دمشق عن الطاولة، رغم أن مصيرها هو المعني الأول بهذه التوافقات. تحضرني الآن تلك اللحظة التي نوقشت فيها جغرافيا الشرق الأوسط وتحولت إلى خرائط في بداية القرن العشرين، كنا غائبين والغياب فرض أن يرسم الحاضر ما يتصل بنا وبمستقبلنا الذي نعيش اليوم.
روسيا أيضاً غابت عن باكو، لكن حضورها في سوريا يبدو اليوم مثل “ظل” إمبراطورية كانت ذات يوم صاحبة اليد الطولى. موسكو تراقب بقلق بالغ كل قاعدة تركية جديدة تُبنى على الأرض السورية، لكنها تجد نفسها في موقف يمكن وضعه في خانة “العجز” أمام ضغوط أكبر تتعرض لها على جبهات أخرى، خاصة في أوكرانيا والعلاقة المعقدة مع حلف شمال الأطلسي. روسيا تدرك تمامًا أن أنقرة تتوسع في مناطق كانت حتى وقت قريب في دائرة النفوذ الروسي، ولكنها في الوقت نفسه لا تملك القدرة على ردعها بشكل حاسم في هذه المرحلة. ومع ذلك، تحافظ موسكو على “حق الاعتراض”.
في تصريحات له من أنطاليا، قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي: “نتشارك مع الروس الرؤية الأمنية في سوريا”. وهذه العبارة تبيّن أن التعاون بين أنقرة وموسكو ليس تحالفًا استراتيجيًا بالمعنى التقليدي، بل هو تحالف مصلحي يهدف إلى الحفاظ على حد أدنى من التوازن في المنطقة. روسيا قد لا تتدخل بشكل مباشر في المواجهات التركية-الإسرائيلية – فيما لو حدثت- على الأرض السورية، ولكنها تظل حاضرة بشكل غير مرئي، تراقب عن كثب كل تحرك قد يهدد مصالحها في المدى الطويل، وربما اختيار باكو لمسرح الظل في اللقاء الإسرائيلي التركي لم يكن بعيداً عن المظلة الروسية الحاضرة الغائبة لما تربط موسكو مع باكو من روابط.
سوريا: الغائب الحاضر
في قلب المعادلة السورية المعقدة اليوم، يغيب السؤال المركزي الذي كان يجب أن يكون في صدارة اهتمامات الجميع: ماذا عن سوريا نفسها؟ من يُمثّلها؟ من هو القادر على التفاوض باسمها؟ من يملك سلطة رسم حدودها، سياسياً وعسكرياً، سواء على الأرض أو في أروقة القوى الكبرى التي تتنازع النفوذ فيها؟
مع انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، واجهت سوريا – وما تزال- تحديات هائلة في تحديد هويتها السياسية الجديدة. الإدارة السورية الجديدة، التي تكونت بعد سقوط النظام، كانت في البداية مجرد حالة انتقالية تطرح رؤى مختلفة ومتناقضة تجاه القدرة على بناء مؤسسات قوية قادرة على إعادة استقرار الدولة. ورغم ذلك، فإن هذه الإدارة تعمل على تجاوز العثرات، إذ تجري – وفق ما يتسرب- تفاهمات خفية مع أنقرة، وتراهن على الدعم الروسي، وتخطو ببطء نحو إعادة بناء الجيش الوطني السوري بعيداً عن عقيدة جيش الأسد الذي تحول إلى مجرد جماعات متمردة وشظايا من بقايا السلطة أو ما اصطلح عليه سوريا ” الفلول”. حتى سياسياً تحاول الإدارة الجديدة أن تمثّل حالة القطيعة مع مسار نظام الأسد، وهذا يظهر جلياً في إصرارها السياسي وإلحاحها على أنها دولة سلام تريد صفر مشكلات مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل التي تحتل الجولان وتنفّذ توغّلات عسكرية وتوسِّع منطقتها العازلة، وتقصف في وضح النهار وظلام الليل ما تبقى من ترسانة عسكرية تتبع للدولة السورية، والصادم – وفق قراءات مختلفة- أن بيانات وزارة الخارجية السورية خرجت عن كل الثوابت السورية حين لم تصف إسرائيل بالاحتلال أو العدو أو الكيان وفق الأدبيات السورية منذ النكبة الفلسطينية.
وبالرغم من كل ما سبق إذا كانت الإدارة السورية الجديدة قادرة على جمع خيوط القرار الأمني في يد واحدة، فإننا قد نكون أمام مرحلة جديدة في تشكيل سوريا، مرحلة يتم فيها بناء جيش وطني جديد يحاكي النموذج التركي، مع إعادة تشكيل الولاء والعقيدة العسكرية بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية الحالية. هذه المرحلة لن تكون سهلة، لأن نجاحها يتطلب توافقًا سياسيًا داخليًا عالياً يتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية العميقة التي أسهم نظام الأسد في تفجيرها. ولكن، إذا نجحت سوريا الجديدة في إعادة بناء جيشها بشكل يتناسب مع التحديات الإقليمية، فإنها قد تنجح في تعزيز مكانتها في محيطها الجغرافي، إذا ما تم تضمين مبادئ من الاستقلالية العسكرية والتحكم الذاتي في قرارها الأمني.
من ناحية أخرى، فإن التفاهمات مع أنقرة، التي بدت أنها تؤتي ثمارها في الأشهر الأخيرة، تشير إلى تحول في العلاقات بين الطرفين، لا سيما في ظل التقارب الأمني التركي-السوري. تركيا تجد وتعتبر نفسها اليوم شريكًا ضروريًا للإدارة السورية الجديدة. لكن هذا التعاون لا يخلو من تحديات ومخاطر، خاصة في ظل حديث أنقرة عن إمكانية واحتمال تواجد دائم أو مؤقت على الأراضي السورية. ولا يخفى على أحد أن تركيا ترى في سوريا مجالاً لتثبيت نفوذها، وقد تتعامل مع هذه التفاهمات على أنها فرصة لتحقيق استراتيجيات أمنية تتجاوز محاربة “التنظيمات الإرهابية” لتصل إلى تعزيز قوتها في منطقة الشرق الأوسط.
أما روسيا، التي تعتبر اللاعب الرئيسي – سابقاً- في الملف السوري، فقد حافظت على وجودها العسكري والسياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، أرسلت رسائل مختلفة للإدارة السورية الجديدة وتراقب اليوم عن كثب كل تحرك للقوات التركية داخل الأراضي السورية، خصوصًا في المناطق التي تشكل نقطة تلاقٍ بين المصالح التركية والإيرانية. ومع تراجع الاهتمام الأميركي، تزداد أهمية الدور الروسي، الذي يبقى عائقًا أمام أي محاولات تركية للتوسع في المناطق الحساسة مثل الساحل السوري.
في هذا السياق، إن المرحلة التي تمر بها سوريا تتطلب إعادة هيكلة عميقة وشاملة ليس فقط للدولة بل للوعي أيضاً. وإذا استطاعت الإدارة السورية الجديدة جمع هذه الخيوط المتناثرة، فإنها قد تكون على أعتاب تشكيل جيش وطني قادر على التفاعل مع جميع القوى الكبرى في المنطقة، سواء كانت تلك القوى عربية أو غير عربية. وهذا البناء العسكري الجديد لن يكون مجرد رد فعل على الضغوط الخارجية، بل سيكون جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء سوريا جديدة تكون أكثر تماسكًا وأقل عرضة للانقسامات الداخلية.
سوريا اليوم تُشبه لوحة جغرافية متباينة الأطراف، تبحث فيها قوى إقليمية ودولية عن مصالح متباينة قد تكون متناقضة أحيانًا، لكنها تتقاطع في تفاصيل النزاع. من الشمال التركي إلى الجنوب السوري، مرورًا بظل أميركي يتقلص يوماً بعد يوم، ورقابة روسية سلبية، تظل سوريا تمثل ساحة اختبار حية للمصالح الإقليمية والدولية. بين الأطماع الإيرانية، والتحركات العسكرية التركية، والتفوق الإسرائيلي الأمني، تظل سوريا أرضًا منقسمة أكثر من كونها دولة واحدة قابلة للحكم والسيطرة. ورغم هذه التحديات، فإن سوريا ليست مجرد ساحة اختبار، بل قد تصبح ميدانًا يمكن أن يُعيد تشكيل قوة الدولة إذا توفرت شروط معينة يعرفها جيداً أصحاب القرار.
التاريخ علمنا أن الميادين التي تتنازعها القوى الكبرى قد تُنتج كيانات جديدة قادرة على النهوض. ففي غياب الدور الأميركي الفاعل، وقدرة روسيا على تقديم نموذج متوازن يعزز استقرارًا داخليًا، لا يوجد من يملأ الفراغ في سوريا سوى من يملك القدرة على فرض إرادته على الأرض. ويبدو أن هذا هو ما سيحدث في الفترة القادمة، حيث قد يؤدي الانسحاب الأميركي التدريجي إلى انكشاف حقيقة أن القوى الفاعلة على الأرض هي التي تكتب مستقبل سوريا. وعلى الرغم من ذلك، تبقى سوريا اليوم في موقع متأرجح بين التطلعات الوطنية والضغط الإقليمي، بين محاولات بناء جيش سوري جديد وبين تقاطع مصالح القوى الأجنبية التي تسيطر على أجزاء من أراضيها. مع كل قاعدة تُبنى، ومع كل طائرة تحلق في سمائها، ومع كل صفقة تُعقد خارج حدودها، تُكتب صفحة جديدة في كتاب تاريخ سوريا الذي سنكون شهوداً عليه. وما نريد أن نشهد عليه حقاً هو أن تنجح الإدارة السورية الجديدة في فرض نفسها كمحور أساسي على طاولة التفاوض الإقليمية، وإعادة بناء الدولة السورية ككيان متماسك وفاعل من دون قواعد عسكرية أجنبية أو انتهاك للسيادة.
تلفزيون سوريا
——————————————
كوري ميلز لتلفزيون سوريا: سأنقل ما سمعته من الشرع إلى ترمب والكونغرس
2025.04.20
قال عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، إنه أتى إلى سوريا “بقلب مفتوح وعقل مفتوح” من أجل استكشاف واقع البلاد وبحث آفاق إقامة علاقات جديدة معها.
وأضاف: “أردت أن أرى ما تعنيه سوريا الجديدة، الحرة، التي تضم مكونات متعددة من المسلمين والمسيحيين والعلويين واليهود”.
وأوضح ميلز أن زيارته جاءت للاطلاع على الوضع الأمني عن قرب، وبحث إمكانات بناء تحالفات قوية، والأهم من ذلك، بحسب قوله: “أن نرى كيف يمكننا أن نساعد الشعب السوري”.
وأردف: “شاهدت الناس في الأسواق والمتاجر، والابتسامات على وجوههم، من الجميل أن ترى ذلك في بلد تمزق بسبب الدكتاتورية والحرب وقصف نظام بشار الأسد”.
وتابع قائلاً: “رؤية هذه الابتسامات تدلّ على أن الناس يشعرون بأن عصراً جديداً قد بدأ، ويتطلعون إلى سوريا قوية ومستقرة”.
خطوات ما بعد العودة إلى أميركا
وفي ما يخص الخطوات المقبلة بعد انتهاء الزيارة، أكد ميلز أنه سيشارك نتائج زيارته مع رئيس الكونغرس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال: “سأنقل الرؤية التي شاركها معي الرئيس السوري ووزير الخارجية حول التحديثات في أنظمتهم، ورغبتهم في إعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، وبناء علاقات صحية مع دول الجوار، إلى جانب تمكين النساء في صلب العملية الحكومية”.
وأضاف: “هذه الرسائل سأنقلها إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وسنرى لاحقاً كيف يمكننا أن نُبقي باب الحوار مفتوحاً مع هذه الحكومة”.
ملف العقوبات الأميركية على سوريا
وبشأن موقفه من العقوبات الأميركية، قال ميلز: “أنا عضو في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، وكذلك في لجان الشؤون العسكرية والأمن الداخلي. صحيح أن السياسات الخارجية والعقوبات بيد الرئيس الأميركي، لكن من خلال لقاءاتي واتصالاتي هنا، أحاول أن أستكشف السبل الممكنة لدعم سوريا”.
وشدد على أنه سينقل رسالة إلى واشنطن مفادها: “كيف يمكننا أن ندعم سوريا لتكون قوية، وأن يكون لها دور ومكانة على طاولة استقرار المنطقة”، مضيفاً أن هذا قد يتجسد عبر “توسيع اتفاقيات أبراهام، أو من خلال سياسات أوسع لتحقيق الاستقرار”.
وختم بالقول: “الهدف الأساسي من زيارتي هو أن أعود بانطباعات شخصية من الداخل السوري، وأن أنقل هذه الانطباعات مباشرة إلى الرئيس ترمب ورئيس الكونغرس”.
عضوان في الكونغرس يزوران سوريا
زار وفد من الكونغرس الأميركي العاصمة السورية دمشق، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، لتقييم الوضع في البلاد والاطلاع على واقع الحياة بعد سقوط النظام المخلوع.
ووصل نائبا الكونغرس الجمهوريان كوري ميلز من ولاية فلوريدا، ومارلين ستاتزمان من ولاية إنديانا، إلى دمشق يوم الجمعة، برفقة عدد من أفراد الجالية السورية المقيمين في الولايات المتحدة، في زيارة وُصفت بأنها “مهمة لتقصي الحقائق”.
ووصف عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستاتزمان زيارته إلى سوريا بأنها كانت “تجربة رائعة”، وذلك في أول تصريح له عقب ختام اجتماعاته مع الحكومة السورية.
——————————-
من دير الزور إلى الحسكة.. القوات الأميركية تغير مواقعها في سوريا
2025.04.20
أكد مصدر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لموقع تلفزيون سوريا عزم القوات الأميركية تخفيض أعداد جنودها وقواعدها في مناطق شمال شرقي سوريا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي شرع في إغلاق ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في المنطقة، في خطوة تعكس التغير في البيئة الأمنية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وأعلن البنتاغون عن تخفيض عدد القوات في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، وذلك في “عملية مدروسة قائمة على الظروف”.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان إنه “اعترافاً بالنجاح الذي حققته الولايات المتحدة ضد داعش، بما في ذلك هزيمتها الإقليمية في عام 2019 في عهد الرئيس ترمب، وجّه وزير الدفاع اليوم بتعزيز القوات الأميركية في سوريا تحت قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب في مواقع مختارة في سوريا”.
وتضمّنت عملية الانسحاب مواقع مهمة مثل “القرية الخضراء” (حقل كونيكو)، و”الفرات” (حقل العمر)، بالإضافة إلى منشأة ثالثة أصغر لم تُذكر تفاصيلها.
وقال المصدر إن واشنطن نقلت قوات وآليات عسكرية ثقيلة الجمعة من قواعدها العسكرية في دير الزور إلى قاعدة “قصرك” بالقرب من الطريق الدولي (M4) شمال الحسكة .
وأشار المصدر إلى أن “القوات الأميركية استخدمت قاعدة قصرك في العام 2019 كنقطة تجمع لقواتها المنسحبة من عين العرب (كوباني) ومواقع بشمالي سوريا قبل أيام من بدء عملية “نبع السلام” التركية في منطقتي رأس العين وتل أبيض شمالي البلاد”.
ومن المتوقع أن تبدأ واشنطن بنقل جزء من قواتها وآلياتها وأسلحتها إلى قواعدها العسكرية في العراق خلال أيام.
ونقلت القوات الأميركية جزءا من جنودها ومنصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية من قواعدها في دير الزور إلى قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة خلال الأيام الماضية وفق المصدر.
وأشار المصدر إلى أن “القوات الأميركية عازمة على تخفيض عدد جنودها وقواعدها العسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا خلال الثلاثة أشهر المقبلة”.
القوات الأميركية ستنتقل إلى الحسكة
وبحسب المصدر فإن القوات الأميركية سوف تتحول إلى التمركز في قواعد رئيسية لا يتجاوز عددها 5 قواعد في مناطق شمال شرقي سوريا وتتركز ثلاثة منها على الأقل في محافظة الحسكة.
وأوضح المصدر أن “بقاء القوات الأميركية في دير الزور مرتبط بالتفاهمات بين “قسد” والحكومة السورية من جهة وبين واشنطن والحكومة السورية من جهة ثانية”.
وشدد المصدر على أن واشنطن أكدت لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” عدم وجود أي خطط بالانسحاب الكلي من سوريا في الوقت القريب مع التأكيد على استمرار عمليات التحالف الدولي في مكافحة تنظيم “داعش” ودعم “قسد”.
وتتمركز القوات الأميركية في سوريا في 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، ويقع 17 موقعا منها في محافظة الحسكة، و9 في محافظة دير الزور، و3 في محافظة الرقة وفق دراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات نشرت في تموز 2024.
—————————–
المقاتلون الأجانب واحتكار السلاح في سورية/ عمار ديوب
20 ابريل 2025
يقتضي الانتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة سياسات وطنية عامّة تقطع مع المرحلة السابقة. يتطلّب النهوض بالدولة إشراك فئات الشعب كافّة وإرضاءها، بغض النظر عن تنويعاتها السياسية والقومية والدينية. وجود مقاتلين أجانب، وفي حالة كارثية في سورية، إلى جانب التنوّع، يستدعي إبعادهم بشكل كامل من شؤون الدولة كلّها، وتحديداً من الجيش والاستخبارات والمناصب السيادية، كما أن حدّة الاستقطاب الطائفي والقومي والضغط الخارجي والحدود مع الدولة الصهيونية يستدعي هذا الإبعاد.
تخلّصت سورية مع زوال نظام الأسد من المقاتلين الأجانب الداعمين له، وهناك ضغط أميركي وتركي، وسوري داخلي، للخلاص من الأجانب الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبالكاد تكتب التقارير الصحافية عن أجانب لدى بقايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتواجه السلطة الحاكمة في سورية نقداً شديداً لوجود المقاتلين الأجانب، ولا سيّما أنّها وضعت بعضهم في مناصب عُليا بالجيش، وأثار الأمر حفيظة السوريين، خاصّة الضبّاط المنشقّين من جيش النظام السابق، فهم من ضحّى بكلّ شيء، والتحق بالثورة، ولا يزالون مُستبعدين من المشاركة في إعادة تأسيس الجيش. كان للمقاتلين الأجانب دور كبير في تصفية فصائل الجيش الحرّ منذ 2012، سواء بتحالفهم مع جبهة النصرة أو “فتح الشام” أو هيئة تحرير الشام أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو “قسد”، وبالطبع، مارس الأجانب ضمن المليشيات الإيرانية أكبر الأدوار في دعم السلطة، وإفشال الثورة. إذاً هناك عدد كبير من المقاتلين الأجانب وفدوا إلى سورية وقاتلوا في مواقع متعدّدة، ويكمن دورهم في تغييب أهداف الثورة وحرف الصراع ليصبح صراعاً طائفياً.
الآن، هناك طلبات داخلية وخارجية للخلاص من الأجانب في ميدان الجيش والدولة، وهي مطالب محقّة، وهي من شروط رفع العقوبات الأميركية والدولية عن سورية، وهناك مطالب كثيرة تتعلّق بإشراك القوى السياسية والاقتصادية والثقافية من خارج مجموعة هيئة تحرير الشام، ومن يدور في فلكها. ورفض إبعاد الأجانب بحجّة قتالهم النظام، وأن هيئة تحرير الشام بذلك تخون المتحالفين معها، وأن هناك مقاتلين أجانب كثيرين اعتُرف بهم في دول كثيرة (كما يقول إعلاميو السلطة)، فيه كثير من عدم فهم واقع سورية الكارثي، والممتدّ بحالة الدمار والإفقار منذ 2011، بل وما قبل 2011، وكذلك فيه تجاهل لدور الأجانب داعمي “الهيئة”، فلقد كانوا ضدّ النظام والفصائل الحرّة معاً، فيُنظَر إليهم أعداءً للثورة السورية، وخطراً كبيراً على إعادة تأسيس الجيش بشكل وطني، وهناك عقائدهم البعيدة من الوطنية السورية، وكان مجيئهم إلى سورية بقصد محاربة “النصيرية” وبناء “دولة الخلافة”، وهناك رفض كامل منهم لأيّ مفرداتٍ تتعلّق بالديمقراطية أو المواطنة أو التعدّدين الديني والقومي. تتعارض رؤى عقائدية كهذه بشكل حاسم مع بناء دولة للسوريين كافّة، والسوريون العلويون جزء منهم بالضرورة. إذاً هناك أسباب كثيرة، وليس طلبات الخارج فقط، تستدعي إبعاد المقاتلين الأجانب.
حاججت كلّ من “قسد” ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بعض الوقت بأن وجود الأجانب في الجيش المُراد تشكيله يُضعف مطالبة السلطة بإبعاد الأجانب الداعمين لـ”قسد”، ولكن الأمر يخصّ أيضاً فصائل السويداء، وحتى الفصائل الداعمة للسلطة ذاتها، فالأغلبية السورية لا تريد مقاتلين أجانبَ في أراضيها. التشكيك بتوجّهات السلطة، وعدم استجابتها لإبعاد هؤلاء الأجانب، ولا سيّما بعد دورهم في مجازر الساحل الطائفية بامتياز، في أوائل الشهر الماضي (مارس/ آذار)، ينتقص من حقّها في احتكار السلاح، إذ ليس من المعقول الموافقة على تسليم السلاح والانتظام في جيشٍ يتشكّل وفيه قيادات أجنبية، أو يتحالف مع جماعات جهادية من أوزبك وشيشان وتركمانستان ومغاربة وسواهم.
أصبحت مسألة إبعاد الأجانب حاسمةً، وتضغط أميركا وأوروبا لإبعادهم بشكل كبير، وهناك تجميد جديد لرفع العقوبات من الاتحاد الأوربي بسبب عدم استجابة سلطة دمشق للشروط الأوروبية، ومنها استبعاد الأجانب، وهناك تقييم سلبي أميركي كبير للسلطة، والاتجاه نحو عدم الاعتراف بها، وبالتالي، هناك أسباب كثيرة تدفع نحو تغيير السلطة توجّهاتها وفكّ العلاقة مع الأجانب العقائديين، وتحويلهم إلى العمل الاقتصادي، وفي حال رفضهم ذلك، فإبعادهم إلى الخارج. وفي الإطار ذاته، لا يجوز السماح لهم بالمشاركة في العمل الدعوي، فالدعويُّ في حالة الأجانب، السلفيين الجهاديين، سيكون متعارضاً مع الوطني، ومع تعزيز الاتجاهات الإسلامية الوطنية.
تتجه السلطة في دمشق إلى تشريع نفسها عبر العلاقة مع الخارج، وإذ بدأت بالشعور بثقل المطالب الأميركية والأوروبية راحت تتجه نحو تركيا والخليج للمساهمة في التخفيف من ذلك الثقل، وجولة الرئيس أحمد الشرع الإقليمية، أخيراً، تأتي في هذا الاتجاه، وبهدف تأمين الدعم وتشريع سلطته، وإن نال بعض الدعمين المادي والسياسي، فإن الشروط الدولية ستظلُّ الأساس في العلاقة مع دمشق. تتعزّز قوّة السلطة تجاه الشروط الدولية عبر الحقوق التي يتمتع بها الشعب، فهل ستعي السلطة أن الشعب هو مصدر الشرعية والقوّة؟
تعيد السلطة الحالية سياسات النظام القديم، الذي أدار ظهره للشعب وتحالف مع إيران ومليشياتها وروسيا، وكانت الحصيلة انهيار حكمه، الذي أُجِّل منذ 2012 إلى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024. وسورية لا تحتمل تكرار السياسات نفسها، وهي في حالة كارثية، وفي المستويات كافّة، وتتطلّب سياسات وطنية في الاقتصاد والتعليم والثقافة والجيش وإدارة مؤسّسات الدولة، وإشراك الفعّاليات السياسية والثقافية وسواها، المستقلة عن السلطة. هنا مصدر الشرعية، ومن هنا الرفض الواسع لتنصيب المقاتلين الأجانب بقيادة الجيش أو جعلهم فصيلاً فيه. ينتهك هذا وطنية السوريين، ويؤسّس جيشاً غير وطني.
تخطئ السلطة في محاولة تشريع نفسها عبر الخارج، فللخارج مصالحه، وهناك أشكال من التعارض بين مصالح الخارج ومصالح الداخل، ويتقلّص التعارض بمقدار الانطلاق من مصالح الداخل، إذ ستكون مصالح الداخل الأساس في أيّ مفاوضات بخصوص النهوض بسورية، وفي غياب الشرعية الداخلية ومصادر القوة الداخلية، ستتعرّض السلطة لضغوط كبيرة، وستنتقل لاحقاً لتصبح أداةً بيد الخارج، وربّما تنهار سريعاً.
قوة السلطة الحالية متأتية من إسقاط النظام التابع وتخليص سورية من النفوذين الإيراني والروسي، ومن شعور الشعب بأن ثورته انتصرت أخيراً. سيتغيّر هذا التفكير كلّه باستمرار إدارة الظهر للشعب. ومسألة المقاتلين الأجانب قضية حساسة في سورية، وستكون قابلة للانفجار في أيّ لحظة، سواء بسبب رؤية هؤلاء الأجانب السلفية المتعارضة مع التديّن السوري السائد، أو رغبتهم في تقييد توجّهات السلطة “الوطنية” الجديدة، أو من خلال الضغوط الخارجية والاستمرار في العقوبات، وهناك الدولة الصهيونية التي تنتقد سلطة دمشق، وتقدّمت باتجاه ثلاث محافظات، بسبب “مخاطر السلفية الجهادية”، كما تدّعي.
سيكون الإصرار على عدم إبعاد المقاتلين الأجانب سبباً في تراجع الدعم الإقليمي والدولي، والمصدر الأساس لشرعية السلطة هو الاستجابة لمصالح الشعب وحقوقه والمسارعة بإبعادهم، ومن دون ذلك ستظلُّ الشرعية منقوصة، وهناك إمكانية لأشكال التدخّل الخارجي، وعكس ذلك حينما تتبنّى السلطة مشروعاً وطنياً وديموقراطياً ويتمظهر في شؤون الدولة كلّها.
العربي الجديد
———————————-
إعادة تموضع أميركي في سورية/ فاطمة ياسين
20 ابريل 2025
لم يكن قد مضى أسبوعان على دخول أحمد الشرع إلى قصر الشعب في دمشق، حتى بادرت الإدارة الأميركية السابقة إلى إيفاد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف لمقابلة مسؤولي سورية الجدد، والتقت بالشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. كان الوفد رسمياً ويمثل الإدارة الأميركية، رغم أن مهمته اقتصرت على أعمال الاستطلاع الدبلوماسي الاعتيادية وتقديم بعض “النصائح”، وربما مرّرت طلبات أميركية قيل إنها سُلمت فيما بعد للشيباني على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، من قبيل البحث عن صحافي أميركي مفقود أو المساعدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وكان من غير الممكن حينها الخوض في وجود القوات الأميركية في الشمال السوري، أو في شكل علاقتها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). مضى على ذلك أكثر من ثلاثة أشهر، وجرت في النهر مياهٌ كثيرة. وجاءت إلى البيت الأبيض إدارة جديدة، وتوصل كل من الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي إلى اتفاق إطاري وقّعاه في دمشق، ليأتي قبل يومين عضوان من الكونغرس في ثاني زيارة لمسؤولين أميركيين إلى سورية، وأول زيارة في عهد ترامب. ورغم أن الزائرَيْن لا يمثلان إدارة ترامب، إلا أنهما سيقدّمان تقريراً إلى مجلسهما، يتضمّن ما بحثاه وما شاهداه وسينطوي بالتأكيد على توصياتٍ محدّدة.
تأتي الزيارة خلال أصداء تتردّد عن بداية إعادة تموضع كبرى للقوات الأميركية في الشمال، تشمل سحب بعضها ودمج بعض القواعد فيما بينها، من دون أن يصدُر أي موقف رسمي حاسم من المسؤولين الأميركيين تجاه القيادة السورية الجديدة. وربما ينتظر العالم، وكذلك الإدارة السورية نفسها، هذا الموقف، نظراً إلى ما يمثله من أهمية لمصير العقوبات العديدة التي طاولت سورية في عهد النظام البائد، وما زال كثير منها قائماً، فالإدارة السورية الجديدة لا تخفي لهفتها لإزالة العقوبات، وهي عقبة حقيقية في بداية مشروع تنموي جاد، باعتبارها تؤثر على جميع الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي الذي جمّد بعضها بالفعل، ولكن هذا لم يكن كافياً لزحزحة الوضع الاقتصادي.
ولا تتوقف أهمية الموقف الأميركي على العقوبات، وإنما ينسحب أيضاً على مصير القوات الأميركية المرابطة في الشمال تحت عنوان محاربة الإرهاب، أو تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بالمهمّة، والأخيرة تسيطر على ما يزيد عن ربع الأراضي من الجغرافيا السورية، وهي عقبة إضافية أمام البدء بدورة اقتصادية وطنية جديدة. ولا تعني إعادة التموضع الأميركي التي رصدتها الكاميرات في الشمال السوري قبل يومين انسحاباً كاملاً، بل يمكن اعتبارها في إطار تحرّك اعتيادي، وإن غادرت بعض القوات بالفعل من هناك.
ترى إدارة ترامب أن سورية الجديدة قدّمت خدمة لها بطرد كل وجودٍ إيراني مباشر أو غير مباشر من المنطقة، وتعتبر وجود أحمد الشرع ضماناً كافياً لعدم تسرّب أسلحة أو مساعدات إيرانية عبر الحدود إلى حزب الله في لبنان، ولكنها، في الوقت نفسه، تعتبر أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل خطراً، ونظام الحكم في سورية الذي لدى أطرافه نزوع إسلامي قد يرتبك في الوقوف بوجه عناصر التنظيم لو حاولوا الظهور من جديد. وتعتقد الولايات المتحدة أن وجود مقاتلين أجانب ضمن صفوف القوات الرسمية يضاعف من هذا التهديد، ولذلك كان أحد شروطها المعلنة التخلي عن أي قيادي أجنبي في صفوف الجيش السوري الجديد. وقد جعل وجود الشرع الولايات المتحدة تكسب نقطة، لكنها ليست متأكدة إن كانت قد خسرت أخرى في الوقت نفسه، وإسرائيل تنظر بعين المتشكّك، وقد بادرت إلى القيام بتحرّكات عسكرية ضخمة ضمن الإطار نفسه. وفي هذا الظرف، لن تغادر أميركا الشمال في القريب العاجل، ولكنها قادرة على تخفيض عدد قواتها من دون إحداث تغيير كبير في التوافقات السياسية والعسكرية داخل سورية.
العربي الجديد
—————————–
رسائل واشنطن لدمشق من تقليص وجودها العسكري بسوريا/ فراس فحام
21/4/2025
كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشكل رسمي في 18 أبريل/نيسان الجاري أنها بدأت توحيد تمركز قواتها في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية العزم الصلب، لتؤدي إلى خفض الوجود العسكري في سوريا إلى أقل من 1000 جندي خلال أشهر.
وقد جاء بيان الوزارة بعد أيام من التحركات الميدانية، وإعادة انتشار للقوات الأميركية المتمركزة شمال شرق سوريا، وبعدما تحدثت وسائل إعلام أميركية عن توجه لإغلاق عدة قواعد عسكرية.
ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في واشنطن، توالت الأنباء عن عزمه سحب القوات من سوريا، في إطار رؤيته لخفض الإنفاق العسكري والتقليل من انخراط بلاده في الحروب.
وربطت واشنطن الانسحاب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بسلوك الإدارة الجديدة، مما جعل سحب القوات الأميركية من سوريا يكتسب في جميع مراحله دلالات إضافية حول واقع ومستقبل العلاقات السورية الأميركية.
تخفيض تدريجي
أفادت تقارير لوسائل إعلام أميركية ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز عما يشبه عملية إعادة انتشار تتضمن أيضا خفض عديد القوات الأميركية المتمركزة في سوريا.
ووفقا للتقارير، فإن التوجه هو خفض عدد القوات الأميركية من 2000 إلى 1400، مع إغلاق 3 قواعد من أصل 8، ثم العمل على إعادة تقييم لدراسة ما إذا كان هناك حاجة لإجراء المزيد من التخفيضات.
وبحسب ما أكدته مصادر ميدانية للجزيرة نت، فإن القوات الأميركية سحبت غالبية قواتها من قاعدة كونيكو في دير الزور، وتتجه على الأغلب لإنهاء وجودها في هذه القاعدة بالإضافة إلى قاعدة أخرى في حقل العمر النفطي، وسيتم إعادة تجميع القوات ضمن قواعد في محافظة الحسكة السورية، أو إقليم كردستان العراق.
ويبدو أن المؤسسة العسكرية الأميركية تعمل على تطبيق رؤية إدارة ترامب التي تتبنى خطة الانسحاب من سوريا، لكن التنفيذ يتم تدريجيا بما يتناسب مع الوضع الأمني والميداني والسياسي.
وبالفعل، فقد ذكرت وزارة الدفاع الأميركية في البيان الذي أصدرته وتحدثت من خلاله عن خفض عدد القوات إلى أنها ستبقى في وضع يسمح لها بتنفيذ ضربات دقيقة ضد فلول تنظيم الدولة.
ومن المتوقع أن تحافظ القوات الأميركية على وجودها في قاعدة أو اثنتين ضمن محافظة الحسكة لاستمرار الرقابة على السجون التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتحتجز فيها الآلاف من المتهمين بالانتساب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حيث لا تزال وزارة الدفاع الأميركية تؤكد أنها ستتعاون مع قسد في مكافحة التنظيم.
وتعتبر مسألة السجون من القضايا المؤرقة لسوريا ودول المنطقة، خاصة العراق والأردن، مع تكرار تلويح قسد بشكل رسمي بإمكانية فقدان السيطرة على هذه السجون في كل مرة كانت تتعرض فيها لتصعيد من قبل الجيش التركي أو القوات الحكومية السورية، وهذا ما دفع الحكومة العراقية في وقت سابق إلى تقديم مقترح للتحالف الدولي يتضمن نقل السجناء إلى سجون ضمن العراق وإجراء محاكمات للسجناء وفقا للقانون العراقي.
لكن بيان المتحدث باسم البنتاغون، الذي أعلن خطة توحيد القوات وتخفيضها، أكد أن أحد الجهود الأساسية الرامية إلى تقليص قدرة تنظيم الدولة هو التخفيف من عدد النازحين والمعتقلين من بين الأفراد المرتبطين بالتنظيم في المخيمات، ومرافق الاعتقال في شمال شرق سوريا، داعيا “دول المجتمع الدولي إلى استعادة رعاياها من بينهم”، في مؤشر على التوجه الجاد للانسحاب التدريجي من سوريا.
وأكدت مصادر في جيش سوريا الحرة، المتمركز في قاعدة التنف، والذي يحظى بدعم القوات الأميركية، إلى أن واشنطن ستحتفظ بانتشارها في هذه القاعدة المطلة على الحدود العراقية، والمواجهة لقاعدة عين الأسد الأميركية داخل الأراضي العراقية، وبالتالي لن تشمل عملية إعادة الانتشار هذه القاعدة التي تلعب دورا مهما في مراقبة الحدود العراقية السورية لمنع تسلل عناصر مسلحة عبر الحدود.
الانسحاب مرتبط بالسلوك
بالتوازي مع عملية إعادة الانتشار وتقليص حجم القوات الأميركية في سوريا، تحدث مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام عن إمكانية أن تعلن واشنطن صراحة التزامها بسيادة سوريا على أراضيها، وإزالة تصنيف الإرهاب عن أعضاء الحكومة الجديدة، وتخفيف العقوبات التي تم فرضها في وقت سابق لتسهيل تدفق المساعدات حال تم تحقيق بعض الشروط.
ووفقا لما سربته وسائل الإعلام الأميركية، فإن من ضمن الشروط “قمع المتطرفين، وعدم السماح للمسلحين الفلسطينيين بالانتشار في سوريا، وتأمين مخزون الأسلحة الكيميائية في البلاد”.
وتشير التسريبات التي نقلتها وسائل الإعلام الأميركية عن مسؤولين في البيت الأبيض إلى أن الاهتمام الأميركي ينصب على عدم عودة إيران، ومنع ظهور تنظيم الدولة، وأن هاتين هما أهم مصالح الشعب الأميركي في سوريا.
ومن المرجح أن عملية تقليص حجم القوات الأميركية الأولية في سوريا جاءت نتيجة ارتياح لفرص تعاون الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، فقد أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن واشنطن تلقت مؤشرات إيجابية من حكومة دمشق فيما يتعلق بمحاربة تنظيم الدولة، كما أن الحكومة السورية تجاوبت مع معلومات استخباراتية أميركية أدت لإحباط 8 مخططات لهجمات كان سينفذها تنظيم الدولة في دمشق.
وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضمن زيارة رسمية، في رسالة على ما يبدو بأن سوريا ستتعاطى مع الملف الفلسطيني من بوابة السلطة المعترف بها عربيا ودوليا وليس من خلال التنسيق مع الفصائل، في تأكيد إضافي على الاستعداد للتعاطي بإيجابية مع شروط الاعتراف بحكومة الشرع ووحدة الأراضي السورية.
آثار تقليص الوجود الأميركي
من المتوقع أن ينعكس تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا على نفوذ قسد بدرجة أساسية، بالإضافة إلى توسيع سيطرة الحكومة السورية، مع تعزيز الهدوء وانخفاض مستوى التوتر بشكل كبير.
وقبل عدة أيام من إعلان الخطة الأميركية لتخفيض عدد القوات في سوريا، كشفت مصادر محسوبة على قسد فشل جهود عقد مؤتمر كردي سوري عام، كان يتم التجهيز له بهدف توحيد وتعزيز الموقف الكردي في مواجهة حكومة دمشق، مع اتهام المجلس الوطني الكردي السوري بإفشال جهود عقد المؤتمر استجابة للتدخلات الخارجية.
وبطبيعة الحال، فإن عدم نجاح الخطوة عكس عدم قدرة قسد على حشد الموقف الكردي خلفها، وربما لإدراك المكون الكردي تغير المواقف الدولية، خاصة أن مغادرة القوافل العسكرية الأميركية للأراضي السورية قد بدأت قبل قرابة شهر من الإعلان الرسمي من وزارة الدفاع عن التوجه لخفض عدد القوات.
وما إن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية خطة تخفيض القوات في سوريا حتى أعلنت قسد وقف إطلاق النار بشكل شامل في منطقة سد تشرين بريف محافظة حلب، التي شهدت اشتباكات عنيفة طيلة الأشهر الماضية بين قسد وفصائل منضوية تحت وزارة الدفاع السورية، مع إعلان سد تشرين منطقة خدمية، والتأكيد على أن مرحلة الحرب انتهت، وسيتم حل الخلافات بين السوريين بالحوار.
ووفقا لمصادر مقربة من حكومة دمشق، فإن اللجان المشتركة بين قسد والحكومة السورية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق تتجهز لإعادة فتح طريق إم فور، قرب محافظة الرقة بعد تسليم مناطق عين عيسى واللواء 93 للحكومة السورية، مع نشر قوات شرطة مدنية، والسماح للسكان المحليين بالعودة، كما ستسيطر القوات التابعة لوزارة الدفاع السورية على المناطق الحدودية وبالأخص الحدود بين سوريا وتركيا.
وأكدت مصادر أميركية أن واشنطن ستنقل السيطرة في دير الزور والرقة إلى القوات الحكومية السورية، مع الاحتفاظ بقاعدة تنسيق قرب سد تشرين للاستمرار في التنسيق بين دمشق وقسد وأنقرة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع الجزيرة نت، فإن دمشق تمسكت طيلة الفترة الماضية خلال المفاوضات مع قسد بانسحاب الأخيرة من المناطق ذات الغالبية العربية، واحتجت بأن هذا المطلب يعكس رغبة السكان المحليين في دير الزور والرقة.
وأشار بيان الخارجية الأميركية الذي صدر عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في سد تشرين إلى دعم واشنطن لوحدة سوريا، حيث رحب البيان بالتهدئة ووقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد، مع الدعوة للعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة.
شكل العلاقة المتوقع
تشهد العلاقة بين الحكومة السورية والولايات المتحدة تطورا بطيئا، حيث يستعد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني لزيارة أميركا إلى جانب كل من وزير المالية يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية، لكن وفقا لمصادر أميركية فقد تم منح الشيباني تأشيرة دخول من فئة “جي 3” المخصصة للحكومات الانتقالية التي لا تعترف بها الولايات المتحدة.
يوجد عوامل عديدة من المحتمل أن تمنع التطور السريع في العلاقات بين دمشق وواشنطن، ومنها استمرار شخصيات غير سورية حتى اليوم في مناصب قيادية ضمن الجيش السوري، وأبرزهم القيادي مختار التركي قائد الفرقة 70 المسؤولة عن تأمين دمشق، وهذا لا يتناسب مع المطالب الأميركية.
من جهة أخرى، ظهرت مؤشرات على عدم وحدة الموقف الأميركي حيال سوريا، فقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 18 أبريل/نيسان الجاري تحذيرات مفاجئة من حصول هجمات على مواقع يرتادها سياح في سوريا رغم التحسن الملحوظ على الصعيد الأمني، وقد صدر هذا التحذير بالتزامن مع زيارة كان يجريها أعضاء من الكونغرس الأميركي تابعين للحزب الجمهوري إلى دمشق تتضمن لقاءات مع الرئيس الشرع، وأبرزهم كوري ميلز عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.
ومن المتوقع أن يركز الجانب الأميركي في الفترة القادمة على فتح قنوات التنسيق الأمنية مع السلطات السورية لضمان استمرار مهام مكافحة الإرهاب، مع تقليص جزئي للعقوبات تبعا لمدى استجابة الجانب السوري للمطالب الأميركية التي من الواضح أنها مطالب أمنية بدرجة كبيرة.
يبدو من المبكر الحديث عن اعتراف سياسي أميركي كامل بالحكومة السورية الحالية، وهذا ما يشير إليه احتفاظ واشنطن بقوات لها في سوريا رغم تخفيض حجمها، واستمرار العلاقة مع قسد بشكل مباشر وليس عن طريق الحكومة السورية.
المصدر : الجزيرة
———————————-
ثنائية الجيش والفصائل/ لمى قنوت
أفواج من الجهاديين من مختلف المشارب عبروا وقاتلوا في سوريا، كـ”حزب الله” الذي تدخل في عام 2012 إلى جانب مجموعات أخرى قاتلت دفاعًا عن النظام البائد، وخرجت أو أُخرجت من البلاد إثر الحرب على وكلاء إيران في لبنان وسوريا، إضافة إلى جهاديي “داعش” و”القاعدة” وغيرهما من الجماعات العقائدية التي ما زال جزء من عناصرها محتجزًا في سجون “الهول” و”روج”، أما الجماعات التي انضمت إلى عملية “ردع العدوان” التي أدت إلى فرار الأسد، فقد تم تعيين بعضهم وتقليدهم مناصب قيادية في الجيش، واليوم تضع واشنطن شروطًا من ضمنها إبعادهم عن تلك المناصب لتخفف العقوبات التي تعوق إنعاش الاقتصاد المنهار.
على صعيد السلطة الجديدة، فقد أرادت لقرارات فصائل “ردع العدوان” أن يكون مؤتمرها “مؤتمر النصر” بمثابة مؤتمر تأسيسي لمرحلة ما بعد النظام الأسدي، وربما، من هنا يُفهم لماذا تتجاهل السلطة الدعوة لعقد مؤتمر وطني جامع، الأمر الذي جعل من التشاركية والحوار والمشاورات تقتصر على “تيارها السياسي” من شرعيين ومقاتلين ومدنيين، ويُفسر أيضًا الطريقة الأدائية التي اختُزل فيها مؤتمر الحوار الوطني لساعات معدودة، والتي قدرت بخمس ساعات، وإغفال مخرجاته أهمية بناء القطاع الأمني، وبضمنه الجيش، في البند العاشر المتعلق بالعدالة الانتقالية، والاكتفاء بالتنصيص على إصلاح المنظومة القضائية فقط، رغم أهميتها في المراحل الانتقالية، والاقتصار على جملة عامة وردت في البند الثالث المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة والذي تضمن جملة “بناء جيش وطني احترافي”.
وفي الواقع، إن بناء جيش بمعطيات الإدارة الحالية، التي تستفرد بتأسيسه وفق أجندتها وخلفيتها الأيديولوجية، القائمة على تقاسم السلطة بناء على الولاء، هو تعيين جهاديين أجانب، بعضهم مطلوبون في دولهم، وقادة خاضعون لعقوبات دولية، وتعيين متورطين في صراعات خارج سوريا، كفهيم عيسى قائد فرقة “السلطان مراد” فيما يُسمى “الجيش الوطني” عبر تجنيد مقاتلين ومدنيين للقتال في النيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو بدعم تركي، إضافة إلى النفوذ الخارجي وتبعية القرار للعديد من الفصائل، والعقلية الغنائمية وتقاطعها مع الفساد، وبذلك نكون أمام جرعة متكاملة من الفشل، أمنيًا ومؤسساتيًا وحقوقيًا وحتى سياسيًا، وتُبقي الباب مشرعًا أمام استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وديمومة الإفلات من العقاب، وتقوّض السيادة، وترفع مصالح الجماعة فوق مصالح الدولة.
لقد بنى نظام الأسدين الدولة الثكنة، أي عسكرة المجتمع، وكذلك التطبيع مع مقولة “من يحرر يقرر” هو ديمومة لعلوية العسكرة وأحكامها الفوقية الإخضاعية في بناء المؤسسات والانتقال السياسي وبناء الدولة، ودون فهم شواغل غالبية السوريين والسوريات في تحقيق القطيعة مع الاستبداد بكل أشكاله، وبناء نموذج أمني يُطمئنهم لا يخيفهم، يقوم على حماية الإنسان وحقوقه، وتعزيز الأمن الإنساني، ويعتمد في بناء القطاع الأمني، وبضمنه مؤسسة الجيش، على قواعد أرستها الدول الحديثة، قائمة على حياده، ومهنيته، وفحص أهلية المنضوين فيه، والرقابة المدنية عليه، أي رقابة المؤسسات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني.
لا شك أن بناء الجيش والانتقال من العقلية الفصائلية وطبيعتها الغنائمية وصراعاتها على الموارد والنفوذ، وتخلصها من الريعية والولاءات الجهوية والطائفية هي عملية صعبة وطويلة الأمد، ويجب أن تتسم بملكية وطنية وإجراء مشاورات وطنية مع مراكز أبحاث مهتمة بإصلاح القطاع الأمني وخبراء الأمن، نساء ورجالًا، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتعددة المتعلقة في بناء القطاع الأمني في دول أنهكها النزاع وترهلت مؤسساتها، وأن يكون البناء جزءًا من استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية التحولية، والتي تقوم ركائزها على المحاسبة ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات والتشريعات، من أجل إعادة الثقة في المؤسسات ومنع تكرار الجرائم والانتهاكات، وإحداث قطيعة مع ثقافة الإفلات من العقاب.
ختامًا، إن بناء الجيش المحايد، وخضوعه للمساءلة الديمقراطية، وضمان ولائه للحكومات المنتخبة ديمقراطيًا، وعدم تدخله في الخلافات السياسية بين المجتمع والحكومة، وبنتائج الانتخابات، وعدم انحيازه إلى دكتاتور أو حزب سياسي، وضمان ألا يقود انقلابًا أو يدعم انقلابًا، لا يمكن أن يتم دون قيود دستورية ومؤسساتية على دور الجيش، وقضاء مستقل، وفصل للسلطات، وثقافة مؤسساتية ومجتمعية تحترم حقوق الإنسان، وإلا فيخسر الجيش شرعيته إذا وجه سلاحه ضد الشعب أو أي فئة منه، وإذا انحاز لمصالح فئوية وتم بناؤه على اللون الواحد.
عنب بلدي
—————————–
الإدارة الأميركية تدرس رد دمشق على مطالب واشنطن/ محمد أمين
21 ابريل 2025
وضعت الإدارة الأميركية مطالب وشروطاً أمام الحكومة السورية، اتخذت حتى اللحظة شكل تسريبات في صحف في الولايات المتحدة، جرى تبريرها من قبل مسؤولين أميركيين في إطار “بناء الثقة”. وجاءت مطالب واشنطن في وقت لم تحسم فيه الإدارة الاميركية حتى اللحظة موقفها من الإدارة السورية التي تسلمت مقاليد الأمور في البلاد منذ إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبينما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الخميس الماضي، إن “الولايات المتحدة لا تعترف حالياً بأي كيان حكومةً سوريةً”، مشددة على أنه “ينبغي للسلطات السورية المؤقتة نبذ الإرهاب وقمعه تماماً”، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرات محدودة لمسؤولين سوريين لزيارة الولايات المتحدة. وسيزور وزير المالية محمد يُسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تُعقد بين 21 و26 إبريل/ نيسان الحالي (اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل). كما منحت تأشيرة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة نيويورك، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع لمجلس الأمن حول سورية الجمعة المقبل.
مطالب واشنطن
في سياق مطالب واشنطن، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، يوم الخميس الماضي، أنه في اجتماع دولي عُقد في بروكسل الشهر الماضي، سلّم مسؤول من إدارة الرئيس دونالد ترامب، من المستوى المتوسط، وزير الخارجية السوري قائمة تضمّ ثماني خطوات “لبناء الثقة” يجب على الحكومة السورية اتخاذها للنظر في تخفيف جزئي للعقوبات.
وشملت القائمة، التي اطّلعت عليها الصحيفة، السماح للحكومة الأميركية بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ضد أي جهة تعتبرها واشنطن تهديداً للأمن القومي. كما طالبت القائمة الحكومة السورية بـ”إصدار إعلان رسمي علني بحظر جميع المليشيات الفلسطينية والأنشطة السياسية” على الأراضي السورية، وترحيل أعضاء تلك الجماعات لـ”تهدئة المخاوف الإسرائيلية”. وتضمنت مطالب واشنطن أيضاً إصدار إعلان رسمي عن دعمها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، أواخر الشهر الماضي، أن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسورية، سلّمت قائمة المطالب للشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسورية في العاصمة البلجيكية بروكسل في 18 مارس/آذار الماضي. وأضافت الوكالة أن من ضمن مطالب واشنطن تدمير سورية أي مخازن أسلحة كيميائية متبقية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وعدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سورية. بالإضافة إلى تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحافي الأميركي الذي فُقد في سورية منذ أكثر من عشر سنوات.
كانت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، التقت الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق بعد أيام قليلة من إسقاط نظام الأسد. ووصفت في حينه اللقاء بـ”الإيجابي”، بُحثت خلاله عدة ملفات، منها انتقال السلطة في سورية، والتطورات الإقليمية ومحاربة تنظيم داعش، ومصير تايس ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد نظام الأسد. وبعد اللقاء، ألغت واشنطن مكافأة وضعتها للقبض على الشرع عندما كان قائداً لـ”هيئة تحرير الشام”، وكانت تقدر بعشرة ملايين دولار، بعد تأكيد المسؤولة الأميركية أنه بدا في صورة “رجل عملي”.
اتخذت واشنطن عقب ذلك عدة إجراءات تجاه العهد الجديد في سورية، لعل أبرزها الرفع الجزئي لعقوبات مفروضة على سورية لمدة ستة أشهر، “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
والتقى الشرع والشيباني، أول من أمس السبت، مع عضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز في قصر الشعب بدمشق. جاء ذلك ضمن زيارة ميلز سورية برفقة عضو آخر في الكونغرس، هو مارلين ستوتزمان، وأعضاء في التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار (saap)، وهو منظمة غير ربحية، الذي نظّم هذه الزيارة لـ”الاطلاع على الأوضاع في البلاد في ظل التغييرات التي تشهدها”. وفي تصريحات صحافية، قال ميلز إن رفع العقوبات الأميركية عن سورية يتطلب الكثير من الخطوات، مؤكداً أن بلاده “تريد رؤية واقع يسود فيه الاستقرار، وحكومة سورية منتخبة بشكل ديمقراطي”.
بشأن مطالب واشنطن ورد السلطة السورية عليها، ذكر الباحث السياسي السوري رضوان زيادة، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “هناك ثمانية مطالب أميركية رئيسية من الحكومة السورية”، موضحاً أن دمشق “ردت على هذه المطالب عبر أربع صفحات”. وأضاف أن “الإدارة الأميركية تدرس الرد حالياً، والتقييم الأولي للرد إيجابي”.
من جانبه، اعتبر الدبلوماسي السوري السابق والمقيم في واشنطن بسام بربندي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن مطالب واشنطن والشروط الأميركية “واقعية”، لافتاً إلى أن “عدداً من هذه المطالب مطبّق بالفعل على أرض الواقع، خصوصاً ما يتعلق منها بإيران وعصاباتها”. أما نشاط “داعش” في سورية، فهو، وفق بربندي، متوقف بشكل “شبه كلي” منذ سقوط نظام الأسد، مضيفاً أن “موضوع العدالة الانتقالية والحكم الذي يمثل كل السوريين هو مطلب سوري قبل أن يكون أميركياً بالأساس”.
موقف ضبابي
لكن مطالب واشنطن هذه أدرجت أيضاً في سياق غياب الموقف الأميركي الواضح من الإدارة السورية الحالية. وبرأي الباحث السياسي السوري مؤيد غزلان، فإن “التردد والضبابية يخيّمان على السياسة الأميركية حيال سورية”، مضيفاً في حديث مع “العربي الجديد” أن الشروط الأميركية الجديدة تثبت أن ما وصفه بـ”سياسة إغلاق الأجفان الأميركية” لا تزال “تمنع الرؤية الموضوعية لحقيقة الواقع السياسي في سورية”. وبيّن غزلان أن من ضمن شروط واشنطن ما هو “محقق فعلاً على الأرض مثل ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، فهي غير موجودة أصلاً على الأراضي السورية في المرحلة الراهنة”. وبرأيه، “لن تكون هناك أي تجمعات من أي جنسية في سورية تهدد أي دولة من دول الجوار. هذه سياسة سورية التي جرى الإعلان عنها والسير بها قدماً منذ أيام التحرير الأولى”.
من جهة أخرى، أشار غزلان إلى أن “من ضمن الشروط الأميركية ما يمس سيادة سورية بشكل واضح وجلي”. واعتبر أن “اشتراط واشنطن قيامها مع قوات التحالف الدولي باستهداف أي شخصية تهدد الأمن القومي انتهاك واضح لسيادة الدولة الوليدة التي انبثقت بعد صمود ثوري لسنوات طويلة ومعركة تاريخية خلصت العالم أجمع من تهديد محور إيران في الشرق الأوسط”. وعدّ “مكافحة الإرهاب والتهديدات المتطرفة لأمن سورية شأناً داخلياً”، مضيفاً أن “سورية هي من تختار الحليف المناسب للمضي في هذا المسار المطلوب سوريّاً، قبل أن يكون مطلوب دولياً، لأنه يهدد أمن المنطقة بأسرها، وهي معايير تتفق فيها دمشق مع المجتمع الدولي بأسره”. بالمقابل، اعتبر بعض المطالب “طبيعية”، موضحاً أن “دمشق أبدت كل الاستعداد والتعاون في ملف ترسانة الأسلحة الكيميائية منذ عدة أشهر”. وباعتقاده، فإن “الحوار المباشر مع دمشق بدلاً من اتباع سياسة المطالب المشروطة هو خير سبيل للوصول إلى توافق نهائي بين الولايات المتحدة وسورية في المنطقة”.
وشدّد على أن “وضع الشعب السوري تحت ثنائية السيادة أو إبقاء العقوبات له جواب واضح من الشعب السوري بأن السيادة تأتي أولاً ولتنتظر العقوبات. ننتظر حتى تتاح فرصة الحوار السوري الأميركي المباشر، وأن تتعامل واشنطن بواقعية أكثر مع الملف السوري لا عبر المطالب عن بعد”. ورأى أن “الولايات المتحدة الأميركية مصرة كما يبدو على وضع الشعب السوري بين الرغبة الملحة برفع العقوبات وشبح اليأس من المطالب الأميركية التي لا تنتهي والتي ترهن السيادة وتقرير المصير”.
وتحتفظ الولايات المتحدة بحضور عسكري مؤثر في سورية منذ نحو عشر سنوات في إطار التحالف الدولي الذي أسسته لمحاربة تنظيم داعش في سورية والعراق. لكن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أعلنت، الجمعة الماضي، أن الجيش الأميركي سيعمل على دمج قواته في سورية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة “عبر اختيار مواقع محددة”، من دون تحديدها. وأضافت أن “هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأميركية في سورية إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة”، أي النصف. وللجيش الأميركي نحو ألفي جندي في سورية موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشمال الشرقي من البلاد الذي يقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ذراع التحالف الدولي البرية في مواجهة تنظيم داعش. ومن شأن الانسحاب الأميركي من الشمال الشرقي من سورية تغيير خرائط السيطرة لصالح دمشق على حساب “قسد” التي لا تزال تسيطر على الجانب الأغنى (بالثروات) من البلاد، مستندة الى دعم واشنطن التي تدفع باتجاه تفاوض جدي بين هذه القوات والحكومة السورية لحسم مصير الشمال الشرقي من سورية تمهيداً لسحب كل الجنود الأميركيين.
——————————————-
الاتحاد الأوروبي وسوريا: شروط تعجيزية أم فتح صفحة جديدة؟/ أحمد زكريّا
19 أبريل 2025
في تحول لافت، وإن كان محسوبًا، كشفت تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن ديناميكية جديدة في التعامل مع الملف السوري.
وبينما تشير هذه التصريحات إلى انفتاح أوروبي نسبي على الحكومة السورية الجديدة، إلا أن “الشروط الفنية” و”الخطوط الحمراء” التي تمت الإشارة إليها ترسم إطارًا مشروطًا لهذا الانفتاح، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة المتوقعة والضغوط الكامنة خلفها.
رسالة واضحة أم حذر استراتيجي؟
تعكس تصريحات كالاس، التي جاءت في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، موقفًا مزدوجًا: الرغبة في دعم استقرار البلاد وإعادة الإعمار، والحذر من منح شرعية كاملة للحكومة السورية الجديدة دون ضمانات ملموسة.
ويتجلى هذا الحذر بشكل واضح في الإصرار على “تقييم العملية حتى الآن”، وربط أي خطوات مستقبلية بـ”الالتزام بشروط فنية وخطوط حمراء”.
وقالت كالاس: “لم نرَ خطوات كثيرة من القيادة السورية الجديدة ولا يزال مستقبل سوريا هشًا للغاية، لكنه يبعث على الأمل”، مضيفةً: “اتفقنا على أننا سنقيّم العملية حتى الآن لأننا رفعنا بعض العقوبات”.
ولفتت إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعمل على اقتراح الخطوات التالية، مع مراعاة الشروط والخطوط الحمراء التي سنضعها أو الشروط التي يجب تحقيقها”. وزادت موضحة: “سنعمل على المواصفات الفنية هناك، ثم نعود إذا كنا مستعدين للموافقة والمضي قدمًا في هذه الخطوة”، مؤكدة على أن “إعادة إعمار سوريا تتطلب توفير الخدمات”.
إبراهيم خولاني، الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يفسر ذلك بالقول: “إن الحديث عن شروط وخطوط حمراء من الاتحاد الأوروبي يشير إلى أنهم ما زالوا مترددين في منح شرعية كاملة للحكومة الجديدة في دمشق، وهذا يعني أن هناك موقفًا حذرًا أو متوجسًا من المسار السياسي الجاري الآن، وأن هناك مخاوف من تكرار أنماط استبدادية أو التواءات سياسية قد تشبه ما كان عليه الوضع في عهد النظام السابق”.
وأضاف في حديثه لـ”الترا سوريا”: “توحي هذه التصريحات بأن الاتحاد الأوروبي يريد من الحكومة الجديدة التزامات ملموسة، قابلة للقياس والمراقبة، مثل احترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات السياسية، وإشراك أطراف أخرى كانت تعارض النظام السابق، وتوحي أيضًا بأن العقوبات ستظل أداة سياسية بيد الاتحاد الأوروبي للضغط على القيادة الجديدة وضمان ألا تنزلق مجددًا في ممارسات الاستبداد والتهميش، وألا تتبنى سياسات لا تتماشى مع المبادئ الأوروبية”.
بينما يفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام علاقة جديدة مع سوريا، فإنه يضع شروطًا صارمة قد تحدد مسار هذه العلاقة
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الشروط مجرد آلية للضغط على دمشق، أم أنها تعبر عن عدم ثقة كاملة في المسار السياسي الجديد؟ يبدو أن الإجابة تكمن في محاولة الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن دقيق بين تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار وضمان ألا تتحول هذه الجهود إلى مظلة لتعزيز سلطة غير مرغوب فيها، حسب تعبير خولاني.
هل التحول الأوروبي مرتبط بالموقف الأميركي؟
لا يمكن تجاهل الدور الأميركي في تشكيل الموقف الأوروبي، فعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بقدر من الاستقلالية في قراراته، إلا أن التنسيق الوثيق بين الجانبين، خاصةً في ملفات الشرق الأوسط، يجعل من الصعب فصل الموقف الأوروبي عن التوجهات الأميركية.
محمد السكري، الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يقول لـ”الترا سوريا”: “لا أعتقد أن هناك تحولًا في موقف الاتحاد الأوروبي، وإنما إعادة توضيح السياسات الأوروبية بما يخص متابعة وتقييم الوضع في سوريا، والتذكير بأن الرفع الجزئي للعقوبات مقترن بإحداث تغييرات مطلوبة بملفات التنوع والانفتاح على جميع المكونات السورية”.
وتابع: “وبلا شك يتأثر الاتحاد الأوروبي بالموقف الأميركي المتوجس، لكن يعتبر موقف الاتحاد أكثر تقدمًا من الجانب الأميركي، وخاصةً في ظل بناء الثقة مع الحكومة السورية والزيارات المتبادلة”.
وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي عزت الشيخ سعيد أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الاستقلالية في اتخاذ قراراته، خاصةً في مواقفه وسياساته الخارجية. ويقول: “لابد أن نذكّر بالمقولة المعروفة، التي تقول إن الاتحاد الأوروبي عملاق اقتصادي ولكنه قزم سياسي؛ بمعنى أنه يشغل دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي، لكنه ذو أداء سياسي ضعيف وتابع لمواقف الولايات المتحدة الأميركية”.
وأضاف لـ”الترا سوريا”، أنه لابد أن نذكر أيضًا التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، منذ أيام، حول تبعية دول الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة، حيث قال: “إن العديد من الدول الأوروبية كانت تفتقر إلى الحزم الكافي في معارضتها لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، ولو كانت أكثر استقلالية واستعدادًا لمواجهة قرارات السياسة الخارجية الأميركية، لربما أمكن تجنب الكارثة الاستراتيجية المتمثلة في غزو العراق”.
وقال الشيخ سعيد: “ما ذكرناه يدلل على أن الاتحاد الأوروبي افتقر سابقًا ويفتقر حاليًا لهذه الاستقلالية في اتخاذ قراراته، خاصةً في مواقفه وسياساته الخارجية، لذلك نرى هذا التردد في موقفه من سوريا وقيادتها الجديدة”.
وضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء
وتابع عزت الشيخ سعيد قائلًا: “كنا نأمل من الاتحاد الأوروبي دعم القيادة الحالية في سوريا، وهي تملك الكثير لتقدمه، في ملفات الأمن وبناء وإدارة الدولة وإعادة الإعمار وتدريب الكوادر في شتى المجالات، ورفع العقوبات الموضوعة على النظام البائد، لتستطيع هذه الدولة الناشئة تجاوز العقبات التي تعترض خروجها من هذا المخاض الصعب، لكنها آثرت وضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء”.
ولفت في سياق حديثه إلى أن “القيادة الجديدة ترتكب عديدًا من الأخطاء، مما ينفر الاتحاد الأوروبي من الانفتاح الذي نرجوه ونعوّل عليه، لكن مواجهة هذه الأخطاء لا تتم بوضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء، بل بالحوار المستمر لتلافي الأخطاء المرتكبة، ومن هنا يبقى الأمل أن يدرك قادة الاتحاد الأوروبي وقادة سوريا أيضًا، أن وجود دولة ناجحة على مرمى حجر من حدودهم يعود بالخير علينا وعليهم، ويبقى الأمل في أن تسعى الدول العربية للمبادرة في الانخراط والمساعدة في بناء سوريا دولة وطنية مدنية ناجحة، تقوم بدورها في محيطها العربي والإقليمي والإسلامي والعالمي أيضًا، كون ذلك يشجع باقي الدول للانخراط في دعم الدولة الوليدة، لتجاوز الوضع الصعب الذي ورثته عن النظام الإجرامي البائد”.
يبدو أن تقييم الاتحاد الأوروبي سيكون بوابة أساسية نحو رفع العقوبات عن سوريا، سواء بشكل جزئي أو كامل، ومع أن القرار الأخير بتخفيف بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل يعكس خطوة أولى في هذا الاتجاه، إلا أن الآليات القانونية والسياسية المعقدة تجعل رفع العقوبات مرهونًا بتحقيق مؤشرات إيجابية واضحة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي نهاية شباط/فبراير الماضي تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي طالت لسنوات قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد. وشمل قرار رفع العقوبات مجموعة من القطاعات الرئيسية التي كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية منذ سنوات، وأبرزها: قطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل الذي كان يعاني بشدة من القيود المفروضة عليه.
كما قرر الاتحاد الأوروبي رفع خمس جهات سورية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وتضم هذه الجهات: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، مؤسسة الطيران العربية السورية.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي له، أن هذه الخطوة تهدف إلى “تمكين تلك الجهات من استئناف نشاطاتها الاقتصادية”، كما تم السماح “بوضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بها تحت تصرف البنك المركزي السوري”.
ووفق إبراهيم خولاني، الباحث المساعد في مركز حرمون، فإن رفع العقوبات يتطلب دليلًا واضحًا على تغيّر فعلي في الوضع السياسي والحقوقي، ويُعد التقييم بوابة نحو رفع العقوبات الجزئي أو المشروط، ويشمل مراجعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، مثل إطلاق سراح المعتقلين، وضمان حرية التعبير والتنظيم السياسي، وإذا وجد الاتحاد الأوروبي مؤشرات إيجابية، فقد يتجه إلى رفع جزئي للعقوبات أو تعليق بعضها، مثل تسهيل التحويلات المالية، وتخفيف العقوبات القطاعية، ومنح استثناءات إنسانية موسعة.
علاوة على ذلك، فإن تقييم الاتحاد الأوروبي قد يكون له تأثير غير مباشر على مواقف دول أخرى، خاصةً الخليجية منها، التي تنتظر إشارات من الغرب قبل المضي في مشاريع إعادة الإعمار أو تقديم الدعم المالي، وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي ليس فقط لاعبًا محوريًا في هذا الملف، بل أيضًا مصدر مرجعية للدول الأخرى، حسب خولاني.
طريق طويل مليء بالتحديات
وبينما يفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام علاقة جديدة مع سوريا، فإنه يضع شروطًا صارمة قد تحدد مسار هذه العلاقة، وفي ظل التداخل بين المصالح الأوروبية والأميركية، وبين الحاجة إلى إعادة الإعمار والحذر من الانزلاق نحو ممارسات سابقة، يبدو أن الطريق ما زال طويلًا ومليئًا بالتحديات.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الحكومة السورية الجديدة من تلبية هذه الشروط؟ وهل سيكون هناك توافق أوروبي أميركي على خطوات مستقبلية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد إلى حد كبير ملامح المرحلة المقبلة في الملف السوري.
——————-
الاتحاد الأوروبي وسوريا: شروط تعجيزية أم فتح صفحة جديدة؟/ أحمد زكريّا
19 أبريل 2025
في تحول لافت، وإن كان محسوبًا، كشفت تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن ديناميكية جديدة في التعامل مع الملف السوري.
وبينما تشير هذه التصريحات إلى انفتاح أوروبي نسبي على الحكومة السورية الجديدة، إلا أن “الشروط الفنية” و”الخطوط الحمراء” التي تمت الإشارة إليها ترسم إطارًا مشروطًا لهذا الانفتاح، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة المتوقعة والضغوط الكامنة خلفها.
رسالة واضحة أم حذر استراتيجي؟
تعكس تصريحات كالاس، التي جاءت في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، موقفًا مزدوجًا: الرغبة في دعم استقرار البلاد وإعادة الإعمار، والحذر من منح شرعية كاملة للحكومة السورية الجديدة دون ضمانات ملموسة.
ويتجلى هذا الحذر بشكل واضح في الإصرار على “تقييم العملية حتى الآن”، وربط أي خطوات مستقبلية بـ”الالتزام بشروط فنية وخطوط حمراء”.
وقالت كالاس: “لم نرَ خطوات كثيرة من القيادة السورية الجديدة ولا يزال مستقبل سوريا هشًا للغاية، لكنه يبعث على الأمل”، مضيفةً: “اتفقنا على أننا سنقيّم العملية حتى الآن لأننا رفعنا بعض العقوبات”.
ولفتت إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعمل على اقتراح الخطوات التالية، مع مراعاة الشروط والخطوط الحمراء التي سنضعها أو الشروط التي يجب تحقيقها”. وزادت موضحة: “سنعمل على المواصفات الفنية هناك، ثم نعود إذا كنا مستعدين للموافقة والمضي قدمًا في هذه الخطوة”، مؤكدة على أن “إعادة إعمار سوريا تتطلب توفير الخدمات”.
إبراهيم خولاني، الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يفسر ذلك بالقول: “إن الحديث عن شروط وخطوط حمراء من الاتحاد الأوروبي يشير إلى أنهم ما زالوا مترددين في منح شرعية كاملة للحكومة الجديدة في دمشق، وهذا يعني أن هناك موقفًا حذرًا أو متوجسًا من المسار السياسي الجاري الآن، وأن هناك مخاوف من تكرار أنماط استبدادية أو التواءات سياسية قد تشبه ما كان عليه الوضع في عهد النظام السابق”.
وأضاف في حديثه لـ”الترا سوريا”: “توحي هذه التصريحات بأن الاتحاد الأوروبي يريد من الحكومة الجديدة التزامات ملموسة، قابلة للقياس والمراقبة، مثل احترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات السياسية، وإشراك أطراف أخرى كانت تعارض النظام السابق، وتوحي أيضًا بأن العقوبات ستظل أداة سياسية بيد الاتحاد الأوروبي للضغط على القيادة الجديدة وضمان ألا تنزلق مجددًا في ممارسات الاستبداد والتهميش، وألا تتبنى سياسات لا تتماشى مع المبادئ الأوروبية”.
بينما يفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام علاقة جديدة مع سوريا، فإنه يضع شروطًا صارمة قد تحدد مسار هذه العلاقة
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الشروط مجرد آلية للضغط على دمشق، أم أنها تعبر عن عدم ثقة كاملة في المسار السياسي الجديد؟ يبدو أن الإجابة تكمن في محاولة الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن دقيق بين تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار وضمان ألا تتحول هذه الجهود إلى مظلة لتعزيز سلطة غير مرغوب فيها، حسب تعبير خولاني.
هل التحول الأوروبي مرتبط بالموقف الأميركي؟
لا يمكن تجاهل الدور الأميركي في تشكيل الموقف الأوروبي، فعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بقدر من الاستقلالية في قراراته، إلا أن التنسيق الوثيق بين الجانبين، خاصةً في ملفات الشرق الأوسط، يجعل من الصعب فصل الموقف الأوروبي عن التوجهات الأميركية.
محمد السكري، الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يقول لـ”الترا سوريا”: “لا أعتقد أن هناك تحولًا في موقف الاتحاد الأوروبي، وإنما إعادة توضيح السياسات الأوروبية بما يخص متابعة وتقييم الوضع في سوريا، والتذكير بأن الرفع الجزئي للعقوبات مقترن بإحداث تغييرات مطلوبة بملفات التنوع والانفتاح على جميع المكونات السورية”.
وتابع: “وبلا شك يتأثر الاتحاد الأوروبي بالموقف الأميركي المتوجس، لكن يعتبر موقف الاتحاد أكثر تقدمًا من الجانب الأميركي، وخاصةً في ظل بناء الثقة مع الحكومة السورية والزيارات المتبادلة”.
وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي عزت الشيخ سعيد أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الاستقلالية في اتخاذ قراراته، خاصةً في مواقفه وسياساته الخارجية. ويقول: “لابد أن نذكّر بالمقولة المعروفة، التي تقول إن الاتحاد الأوروبي عملاق اقتصادي ولكنه قزم سياسي؛ بمعنى أنه يشغل دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي، لكنه ذو أداء سياسي ضعيف وتابع لمواقف الولايات المتحدة الأميركية”.
وأضاف لـ”الترا سوريا”، أنه لابد أن نذكر أيضًا التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، منذ أيام، حول تبعية دول الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة، حيث قال: “إن العديد من الدول الأوروبية كانت تفتقر إلى الحزم الكافي في معارضتها لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، ولو كانت أكثر استقلالية واستعدادًا لمواجهة قرارات السياسة الخارجية الأميركية، لربما أمكن تجنب الكارثة الاستراتيجية المتمثلة في غزو العراق”.
وقال الشيخ سعيد: “ما ذكرناه يدلل على أن الاتحاد الأوروبي افتقر سابقًا ويفتقر حاليًا لهذه الاستقلالية في اتخاذ قراراته، خاصةً في مواقفه وسياساته الخارجية، لذلك نرى هذا التردد في موقفه من سوريا وقيادتها الجديدة”.
وضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء
وتابع عزت الشيخ سعيد قائلًا: “كنا نأمل من الاتحاد الأوروبي دعم القيادة الحالية في سوريا، وهي تملك الكثير لتقدمه، في ملفات الأمن وبناء وإدارة الدولة وإعادة الإعمار وتدريب الكوادر في شتى المجالات، ورفع العقوبات الموضوعة على النظام البائد، لتستطيع هذه الدولة الناشئة تجاوز العقبات التي تعترض خروجها من هذا المخاض الصعب، لكنها آثرت وضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء”.
ولفت في سياق حديثه إلى أن “القيادة الجديدة ترتكب عديدًا من الأخطاء، مما ينفر الاتحاد الأوروبي من الانفتاح الذي نرجوه ونعوّل عليه، لكن مواجهة هذه الأخطاء لا تتم بوضع الشروط ورسم الخطوط الحمراء، بل بالحوار المستمر لتلافي الأخطاء المرتكبة، ومن هنا يبقى الأمل أن يدرك قادة الاتحاد الأوروبي وقادة سوريا أيضًا، أن وجود دولة ناجحة على مرمى حجر من حدودهم يعود بالخير علينا وعليهم، ويبقى الأمل في أن تسعى الدول العربية للمبادرة في الانخراط والمساعدة في بناء سوريا دولة وطنية مدنية ناجحة، تقوم بدورها في محيطها العربي والإقليمي والإسلامي والعالمي أيضًا، كون ذلك يشجع باقي الدول للانخراط في دعم الدولة الوليدة، لتجاوز الوضع الصعب الذي ورثته عن النظام الإجرامي البائد”.
يبدو أن تقييم الاتحاد الأوروبي سيكون بوابة أساسية نحو رفع العقوبات عن سوريا، سواء بشكل جزئي أو كامل، ومع أن القرار الأخير بتخفيف بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل يعكس خطوة أولى في هذا الاتجاه، إلا أن الآليات القانونية والسياسية المعقدة تجعل رفع العقوبات مرهونًا بتحقيق مؤشرات إيجابية واضحة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي نهاية شباط/فبراير الماضي تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي طالت لسنوات قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد. وشمل قرار رفع العقوبات مجموعة من القطاعات الرئيسية التي كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية منذ سنوات، وأبرزها: قطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل الذي كان يعاني بشدة من القيود المفروضة عليه.
كما قرر الاتحاد الأوروبي رفع خمس جهات سورية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وتضم هذه الجهات: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، مؤسسة الطيران العربية السورية.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي له، أن هذه الخطوة تهدف إلى “تمكين تلك الجهات من استئناف نشاطاتها الاقتصادية”، كما تم السماح “بوضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بها تحت تصرف البنك المركزي السوري”.
ووفق إبراهيم خولاني، الباحث المساعد في مركز حرمون، فإن رفع العقوبات يتطلب دليلًا واضحًا على تغيّر فعلي في الوضع السياسي والحقوقي، ويُعد التقييم بوابة نحو رفع العقوبات الجزئي أو المشروط، ويشمل مراجعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، مثل إطلاق سراح المعتقلين، وضمان حرية التعبير والتنظيم السياسي، وإذا وجد الاتحاد الأوروبي مؤشرات إيجابية، فقد يتجه إلى رفع جزئي للعقوبات أو تعليق بعضها، مثل تسهيل التحويلات المالية، وتخفيف العقوبات القطاعية، ومنح استثناءات إنسانية موسعة.
علاوة على ذلك، فإن تقييم الاتحاد الأوروبي قد يكون له تأثير غير مباشر على مواقف دول أخرى، خاصةً الخليجية منها، التي تنتظر إشارات من الغرب قبل المضي في مشاريع إعادة الإعمار أو تقديم الدعم المالي، وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي ليس فقط لاعبًا محوريًا في هذا الملف، بل أيضًا مصدر مرجعية للدول الأخرى، حسب خولاني.
طريق طويل مليء بالتحديات
وبينما يفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام علاقة جديدة مع سوريا، فإنه يضع شروطًا صارمة قد تحدد مسار هذه العلاقة، وفي ظل التداخل بين المصالح الأوروبية والأميركية، وبين الحاجة إلى إعادة الإعمار والحذر من الانزلاق نحو ممارسات سابقة، يبدو أن الطريق ما زال طويلًا ومليئًا بالتحديات.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الحكومة السورية الجديدة من تلبية هذه الشروط؟ وهل سيكون هناك توافق أوروبي أميركي على خطوات مستقبلية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد إلى حد كبير ملامح المرحلة المقبلة في الملف السوري.
——————-
==============================
عن العدالة الانتقالية
—————————–
العدالة الانتقالية الحسّاسة للجندر في سوريا.. حوار مع لمى قنوت
21 نيسان 2025
مايا البوطي
“من دون مشاركة النساء بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن، ومشاركة النسويات والنسويين تحديداً، ستكون العدالة من وجهة نظر الذكور الممتثلين جندرياً فقط، وبالتالي سيبقى الأثر الجندري الواسع للجرائم والانتهاكات غير مرئيّ” تقول الباحثة النسوية لمى قنوت في هذه المقابلة التي تقدّم فيها مقاربتها للعدالة الانتقالية في سوريا من عدسةٍ حسّاسةٍ للجندر، مقاربةٌ مبنية على دراسةٍ ذات صلة أجرتها في العام ٢٠١٩.
في ظلّ متغيّراتٍ متسارعة نعايشها منذ سقوط نظام الأسد، لا يزال ملف العدالة الانتقالية على رأس المطالب التي يجب العمل عليها. فبعد تاريخٍ دمويّ لحكم آل الأسد، تكثّف في المقتلة في الأعوام الثلاثة عشر الأخيرة، لم تتوقّف مطالبة السوريين/ات بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهن/م. مع ذلك، لايزال هذا الملف بانتظار إجراءاتٍ تُعجّل العمل عليه وتعطيه حقه على جدول القضايا المُلحة.
يشكّل هذا الملف دعامةً ضامنةً للسلم الأهليّ في سوريا، خصوصاً بعدما شهدناه من مجازر مؤسفة في الساحل السوري، جاءت لتعكّر سلاماً منشوداً يلفّ البلاد مع نهاية حقبة الإجرام الأسدي. تعكس هذه المجازر وما رافقها من خطاب كراهيةٍ على مواقع التواصل وبعض منصّات الإعلام السوري، الحاجة للمحاسبة سبيلاً لشفاء الجراح وتحقيق العدل وتعزيز الأمن.
وبسبب قلّة الأبحاث في مجال العدالة الانتقالية، في السياق السوري، يُعتبر البحث الذي أجرته الباحثة لمى قنوت “العدالة الانتقالية الحساسة للجندر في سوريا” (2019)، مرجعاً مهماً لفهم آليات العدالة الانتقالية من خلال عدسةٍ تضمينية، تراعي منظور النساء وتمثيلهنّ في هذا المسار الذي يُعتبر ضمانةً للسلم الأهلي في سوريا.
فيما يلي حوارٌ معها حول بحثها وأفق العدالة الانتقالية في سوريا.
(1): قمتِ في خضمّ بحثك بتعريف العدالة الانتقالية وكيف يمكن لها أن تكون عدالةً مراعيةً لمنظور النوع الاجتماعي الحسّاس، هل لك أن تخبرينا عن هذا التعريف باختصار، ضمن رؤيتك وفهمك للسياق السوريّ؟
ينطلق تعريفي للعدالة الانتقالية الحسّاسة للجندر من التعريف الشائع، باعتباره تعريفًا لا يشتبك مع البنى القمعية غير المعسكرة مثل الطبقية والنظام الأبوي، فكان لابد من تعريفٍ ينطلق من العدسة النسوية التقاطعية، المتمحورة حول ومع الضحايا، ليعمم على كامل المسار، بدءاً من المساواة في المشاركة والتمثيل العريض للنساء بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن، وفهم وتحليل تطور أدوارهن وتجاربهن قبل وخلال وبعد النزاع، وديناميات السلطة في المجتمع وجميع المؤسسات، ومن ضمنها مؤسسة الأسرة، التي سمحتْ وسهّلت حدوث الجرائم والانتهاكات والعنف بكافة أشكاله، قبل وخلال النزاع، لتشمل خريطةُ الانتهاكات أثرها المباشر وغير المباشر عليهن، وعلى الأجيال، بشكلٍ تقاطعي، ويكون التخطيط لتدابير عدالةٍ انتقاليةٍ تحولية، معنيةٍ بتفكيك هياكل السلطة وإحداث تغييرٍ جذريّ، عبر ركائزها المتمثلة في معرفة الحقائق والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات والتشريعات.
(2): بيّنتِ في البحث أن عنف النظام لم يبدأ مع اندلاع الثورة في عام 2011، وتقترحين تضمين ما سبق الثورة في مسار العدالة الانتقالية.
محطات عنف النظام قبل الثورة عديدة، ومن حق السوريين والسوريات تضمين كافة أشكال الجرائم والانتهاكات مثل مجازر حماة في الثمانينات، وفي السجون مثل سجن المزة وتدمر، وفي إحصاء عام ١٩٦٢، وانتفاضة الكورد عام ٢٠٠٤.
(3): تؤكدين على ضرورة عدم الاكتفاء بالبحث في عنف النظام ضد الناجيات من الاعتقال من منظورٍ يقتصر على العنف الجنسيّ، كيف يتم ذلك؟ وما أهمية ذلك في سياق تعزيز الحساسية المراعية للنوع الاجتماعي؟ وكيف يساهم اشراكُ النساء بمسار العدالة الانتقالية بتحقيقها؟
لأن اتجاهات العدالة بالنسبة للعديد من المنظمات العاملة على العدالة الانتقالية تركِّز فقط على العنف الجنسيّ، ومن ضمنه الاغتصاب، وعلى رغم أهمية ذلك، إلا أن تجاهل المروحة الواسعة للجرائم والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة التي تعرّضن ومازلن يتعرضن لها، ونزع الأسباب التي أدّت وتؤدي إلى هشاشتهن تجاه الاستغلال والعنف الجنسي كالإفقار والتشريد القسري وظروف المخيمات وعدم القدرة على العمل واستغلال بعض موظفي المساعدات الإنسانية، إضافةً إلى تجاهل العنف الجنسي الذي يطول الرجال والفتيان، كل ذلك يرسخ في الوعي العام المرأةَ الجسدَ، و/أو الوعاء، المرأة بوصفها شرف ذكر/ذكور العائلة، أيْ لا شرف مستقلّاً لها، وهي مسؤولة عنه. وباستثناء خبيرات الجندر والمنظمات النسوية العاملة على العدالة الانتقالية لا تهتم باقي المنظمات، التي يقودها عادةً رجال، بالعدالة التي تريدها النساء بتنوعاتهن وسياقاتهن والفئات المهمشة الأخرى، ولا يهتمون بآرائهن حول خريطة الجرائم الانتهاكات.
(4): عملتِ على البحث في فترةٍ كان فيها نظام الأسد قائماً. أوضحتِ حينها أن العدالة الانتقالية تحت بند القرار2254 هي عمليةٌ منقوصة، مجادِلةً بأنه إن لم تتمّ محاسبة مجرمي الحرب لا يمكن الوصول إلى عدالةٍ شاملة. الآن ومع سقوط النظام، كيف من الممكن برأيك تطبيق عدالة اجتماعية تشمل جميع الفئات وتراعي الحساسية تجاه قضايا النساء؟
العدالة الانتقالية إن لم تشمل وتطال جرائم وانتهاكات جميع الأطراف، ومن ضمنها الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في الساحل مؤخرًا، تكون عدالةً منقوصة. وكما كان الأمر بوجود نظام الأسد سابقًا كطرفٍ في قرار 2254، نواجه الآن تحدّياً يتعلق بالأطراف الأخرى ومن ضمنها الفصائل المنضوية في وزارة الدفاع، أو تلك التي ستنضوي فيها فيما بعد، فلا يمكن بناء سوريا الجديدة في تجاهل أو حماية أو التواطؤ مع مجرمين أو مشتبهٍ بهم من دون مساءلةٍ ومحاسبةٍ وجبر ضرر الضحايا، ولا يمكن اصلاح مؤسسات الدولة من دون إجراءات العزل السياسي.
وعن الشق الثاني من السؤال، أعتقد أن بناء عدالةٍ انتقاليةٍ تحويلية يمهد الطريق لبناء عدالةٍ اجتماعيةٍ من منظورٍ نسويٍّ تقاطعيّ، كإطار العدالة الإنجابية التي تتقاطع مع قضايا وهياكل متعددة مثل، الإفقار، واللجوء، والنزوح، والهجرة، والمواطنة، والإعاقة، والرأسمالية، والمنظومة الأبوية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري وعنف الشريك الحميم، والعدالة البيئية، وسلطوية وذكورية المؤسسة الطبية، والقوانين والأعراف المحلية، والاحتلال والإرث الكولونيالي، والتمييز العنصري المُمأسّس، والاستبداد بكل أشكاله، الذي يعيق حق الأفراد بالسيادة التامة على أجسادهم/ن، وحرياتهم/ن في الاختيار، وحقوقهم/ن الإنجابية، ونوع البيئة التي يرغبون/ن في العيش فيها.
(5): تكلمتِ في بحثك عن جبر الضرر بأشكاله المادية والمعنوية، هل بوسعك مشاركة طرق وأشكال جبر الضرر معنا؟
أشكال جبر الضرر متعددة، فردية وجماعية ومناطقية، وقد تم تلخيصها بـرد الحقّ والتعويض وإعادة التأهيل وتدابير الإرضاء وضمانات عدم التكرار. وتمتد التعويضات الفردية منها، مثلاً، إلى المعاشات وفرص التعليم والتدريب والوصول إلى الخدمات الصحية وقضايا الأرض والسكن والملكية وإعادة التأهيل النفسي، إضافة إلى برامج جبر الضرر الجماعي واعتذاراتٍ رسمية وتدابير رمزية أخرى، ولكن العدسة النسوية التقاطعية ركزت على فحص علاقات القوة والسلطة من أجل تغيير البنى التمييزية ضد النساء والفتيات بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن، والفئات المهمشة، ويحتوي كتابي على أمثلةٍ عن تجارب دولية متعددة.
فصل الموظفين في الساحل السوري.. غياب “العصا السحرية” يرافق الحكومات السورية!
25 آذار 2025
(6): تكلمتِ عن ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان وقف الظلم المتجذّر في بنيتها، كيف يمكن تحقيق هذا الأمر مع ما نشهده في سوريا من تسريحٍ للموظفين-ات ووقف صرف رواتب العاملين/ات في بعض المؤسسات والقطاعات؟
تعتبر إعادة هيكلة المؤسسات، وخاصة قطاعيّ الأمن والعدالة، صيغةً وقائيةً تساهم في منع تكرار الجرائم والانتهاكات، ولكن النهج الذي اتبعته الإدارة الحالية في معالجة الفساد والترهل المؤسساتي نهجٌ متسرعٌ وتعسفيّ، لم يُبنَ على دراسة ملفات الموظفين الوهميين أو ما يعرف بـ “الموظفين/ات الأشباح” ومن يتقاضون رواتب من عدة مؤسساتٍ حكومية، فانسحب التسريح التعسفي على الكثير من العمال والعاملات، وأُعطي البعض إجازاتٍ قسرية، الأمر الذي زجّ بهم وبأسرهم في دائرة البطالة والإفقار وهدر الحقوق. وقد تناولت في مقالي المعنون بـ “عمال وعاملات في مرمى إجراءات تعسفية” بأنه في حال تأخر تشكيل هيئةٍ للعدالة الانتقالية، يجب تشكيل لجنةٍ محايدةٍ ومستقلة، تضم قانونيين وممثلين عن النقابات والاتحادات المهنية وخبراء في العدالة الانتقالية، من النساء والرجال، تعمل وفق عدة مستويات، ويتقاطع عملها فيما بعد مع تدابير العدالة الانتقالية الأخرى، المتمثلة في المحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي والتشريعي، وعلى اللجنة أن تتبع نهجًا شاملًا متكاملاً عبر مجموعة خطوات، تبدأ من تعليق نصوصٍ في قوانين العمل، تلك التي منحت امتيازاتٍ لحزب البعث المنحل، وتفحص سجلات جميع الموظفين، وتحدد الوهميين منهم، وتطالب المقتدرين باسترداد قيمة الرواتب التي قبضوها من دون عمل، ولا تقوم بإجراء تسوياتٍ للموظفين المتورطين، نساءً ورجالًا، في الفساد واسع النطاق والجرائم الاقتصادية لحين مسائلتهم ومحاسبتهم، وتعمل على استرداد الأموال العامة المنهوبة، كما ويجب التحقيق بشأن الموظفين المنتَدَبين، نساءً ورجالًا، إلى مؤسسات حزب البعث والمنخرطين في ميليشياته، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وتطبيق العزل السياسيّ على موظفي الدولة من رموز النظام السابق، الذين حرّضوا على العنف أو تلطختْ أيديهم بالدماء، ويحب إعادة هيكلة الملاكات وتوزيعها في مؤسساتٍ أخرى حسب الخبرة والمهارة ومكان الإقامة، مع الاستمرار في تدريبهم وتأهيلهم.
(7): كيف يمكن ضمان وجود المحاسبة وتنظيم محاكمات، في وقتٍ أجرت فيه هذه الإدارة تسوياتٍ اتسمت بعدم الشفافية، وتسري أحاديث عن تصفيات وانتقامات؟ بكلام آخر، كيف يمكن الموازنة بين المحاسبة وضمان السلم الأهلي؟
تتبع الإدارة الجديدة نهجًا غير شفّاف بما يتعلق بالتسويات التي تُبرمها مع مرتكبي جرائم اقتصادية وجرائم حرب وانتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان، وهو نهجٌ يتعارض مع تدابير العدالة الانتقالية ويضرّ بالسلم الأهلي، وقد رأينا مشاهد الغضب العارم في حي التضامن مؤخرًا، مع ظهور أحد مجرمي مجزرة التضامن فيها. وحده إطلاق مسار العدالة الانتقالية المترافق مع حظر وتجريم خطاب الكراهية قانونيًا، أي “حظر أيّة دعوةٍ إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف” كما تنص (المادة 20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويمكن أن يستنير القانون بـ “خطة الرباط” التي طوّرتها الأمم المتحدة كي لا يمسّ القانون حرية التعبير، ويجب أن تتوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الساحل، وتخضع الجرائم التي ارتُكبت إلى تدابير العدالة الانتقالية في المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ومعرفة الحقيقة، كما لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن يُبنى القطاع الأمنيّ بمشاركة مجرمي حرب.
(8): نريد أن نتوقف عند “الحوار الوطني”، هل كان ذا أهميةٍ لمسار العدالة الانتقالية؟ وما هي ملاحظاتك حول الكيفية التي تم بها، ونتائجه؟ وهل تجدين تمثيل النساء عادلاً فيه؟
مؤتمر الحوار هو استحقاقٌ وطنيّ يجب أن يكون بداية لحواراتٍ مطولة وممتدة، لا حدثًا ناجزًا، أدائيًا، سُلق على عجل، واكتفى مهندسوه ولجنته التحضيرية بتوجيه دعواتٍ طغى عليها مزيجٌ من الشللية والاستنسابية، من دون أيّة معايير واضحة وشفافة، شارك فيه حوالي 600 شخص، واستغرقت حواراته عدة ساعات، قُدرت بخمس ساعات، نجمتْ عنها مخرجاتٌ عامة استئناسية غير ملزمة، حُرمت فيه الأحزاب والكتل السياسية والنقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، ومن ضمنها النسائية والنسوية، من تمثيل نفسها بنفسها.
أما بخصوص مخرجاته فهي لم تحوِ أيّ ذكر لأهمية عقد مؤتمرٍ وطنيٍّ تأسيسيّ تنجم عنه لجنةٌ منتخَبةٌ لكتابة دستورٍ دائمٍ للبلاد، وتجاهَل البند السادس والذي ينص على: “إعداد دستورٍ دائمٍ عبر لجنةٍ دستوريةٍ تضمن التوازن بين السلطات…” تحديد الآلية والجهة التي يفترض بها أن تكون منتخَبةً من قبل مؤتمرٍ وطني، وتم استخدام مصطلح “التوازن بين السلطات” بدل الفصل بين السلطات، وحصر البند العاشر تحقيق العدالة الانتقالية عبر محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، ولم يذكر الركائز الأخرى المتمثلة في معرفة الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات والتشريعات، وأضيف على هذا البند في النسخة المعدلة التي نشرتها سانا إصلاح المنظومة القضائية والتشريعات فقط، ولم يرد في المخرجات كلمة ديمقراطية، بينما كلمة المواطنة أضيفت في النسخة التي نشرتها سانا، ودمج البند الثامن، حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع، بينما كان يجب أن يُخصّص بندٌ لكل قضية منها، أما البند العاشر والمتعلق بترسيخ “مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب” فلم يشمل أشكال التمييز ضد النساء بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن والفئات المهمشة، بالإضافة إلى نقاط أخرى.
أما بخصوص تمثيل النساء، فقد تناولت في مقالي المعنون بـ “فجوات ونقاط ضعف جلسات الحوار الوطني”، ضعف وجود النساء من كافة الاختصاصات والاهتمامات، ومن ضمنهن السياسيات والإعلاميات والمدافعات عن حقوق النساء والقضايا الأخرى. وأشرتُ إلى أن حصر اللقاءات على المدن الرئيسية حرم العديد من المفقرين في الأرياف، نساءً ورجالًا، غير القادرين على تحمل نفقات النقل والإقامة للمشاركة، وأن اللقاءات المخصصة لبعض المحافظات والتي عُقدت في دمشق، كالرقة مثلًا، أثرتْ على نسبة المشاركة في اللقاء، وخاصة النساء، اللواتي قُدّر عدد من حضر منهن بأربع فقط. ناهيك على أن اللجنة التحضيرية للحوار، وباستثناء السيدتين هند قبوات وهدى الأتاسي، كانوا من لون واحد.
(9): ما أهمية مشاركة النساء في العدالة الانتقالية وعمليات السلام في سوريا الجديدة؟
من دون مشاركة النساء بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن، ومشاركة النسويات والنسويين تحديداً، ستكون العدالة من وجهة نظر الذكور الممتثلين جندرياً فقط، وبالتالي سيبقى الأثر الجندري الواسع للجرائم والانتهاكات غير مرئيّ، وسيغيب النهج التحوّلي للعدالة الانتقالية. وباستثناء العنف الجنسيّ، فإن حزم العنف المترابطة والمركّبة بكافة تقاطعاتها على النساء والفتيات لن تكون مضَمّنة، أي سيتم الحدّ من العنف المُعسكِر في الشوارع والمساحات العامة، وسيبقى عنف وسلطوية المنظومة الأبوية وهياكل القمع الأخرى مسلّطاً عليهن وعلى أجسادهن في جميع المساحات.
(10): ما هي أهم خطوة نحتاجها الآن لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا؟ أو هل لديك توصيات بخصوص العدالة الانتقالية والسلم الأهليّ في سوريا؟
بالنسبة للعدالة الانتقالية فأنا أعتقد أنه من الضروري خلق شبكةٍ واسعة تضم روابط الضحايا وخبراء العدالة الانتقالية، رجالًا ونساءً بتنوعاتهن، والمنظمات المشتغلة عليها، والاستفادة من جميع الكفاءات والاختصاصات والمهارات المتنوعة لدعم هذا المسار، بحيث ترفد هذه الشبكة وتدعم هيئةَ العدالة الانتقالية التي ستتشكّل، لكن خشيتي من الآلية التي ستتشكل فيها اللجنة، وهل ستحظى بالاستقلالية اللازمة، أو سيتعرض المسار لعملية سلق، وشكلٍ أدائي كما حصل مع الحوار الوطني، ولذلك يمكن للشبكة أن تمارس دورها النقدي والاستشاري والمعرفي في دعم المسار.
كما أن لجان السلم الأهلي المحلية وتدابير العدالة الانتقالية التحولية، مساران يدعمان بعضهما بعضاً للوصول إلى سلامٍ مستدام ومصالحةٍ وطنية.
لمى قنوت
كاتبة وباحثة، سياسية مستقلة، نسويّة، لها عمودٌ أسبوعيّ في جريدة عنب بلدي. صدر لها ثلاثة كتب عن المشاركة السياسية للنساء السوريات، والعدالة الانتقالية الحسّاسة للجندر، والتاريخ الشفوي لناجيات سوريات من الاعتقال. شاركت قنوت في تأسيس وإدارة عددٍ من منظمات المجتمع المدني.
حكاية ما انحكت
——————————-
إرهابيون حتى يثبت العكس!/ غزوان قرنفل
تحديث 21 نيسان 2025
من عجائب هذا الزمان أن يبقى الأحرار الذين اقتيدوا أو أحيلوا الى محكمة “الإرهاب”، زمن النظام المدحور، معلقين على صليب انتظار قرار لجنة قضائية قرر وزير العدل تشكيلها، لتقوم بمراجعة مختلف الملفات القضائية والتدقيق فيها للتثبت من مدى مخالفتها للمعايير القانونية عند الفصل في تلك الدعاوى، وعما إذا كانت تستخدم لقمع الحريات الأساسية للناس.
فقد أصدر وزير العدل مؤخرًا قرارًا يقضي بتشكيل “لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وستتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلًا قانونيًا لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهريًا، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية”.
وبخلاف ما يراه زملاء آخرون نكن لهم كل احترام، من أن القرار يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، وأنه لا بد من إجراء تلك المراجعات قبل إلغاء الأحكام وفق الأصول القانونية، رغم إقرارهم فيما يكتبون أو يصرحون بأنها محكمة استثنائية تم تشكيلها خلافًا للقانون، لأنها لا تراعي شروط المحاكمات العادلة، وأنها واحدة من الأدوات التي وظفها النظام للنيل من المناهضين له ومعارضيه، ومع ذلك لا بد، وفق رأيهم، من مراجعة أحكامها ضد المعارضين للتثبت من مخالفتها للمعايير القانونية وفق قرار الوزير قبل أن يتم إلغاء تلك الأحكام.
عجبًا، إذا كان هؤلاء الزملاء وغيرهم كثير من الحقوقيين ورجال القانون يقرون بعدم مشروعية المحكمة، ويطعنون في نزاهتها واستقلالها، وفي أنها لا توفر محاكمات عادلة، وأنها مجرد أداة للبطش بالمعارضين، ومع ذلك يعتبرون أن قرار الوزير خطوة بالاتجاه الصحيح.
ثم ألم تنص المادة “48” من الإعلان الدستوري الناظم لعمل السلطة خلال هذه المرحلة الانتقالية على “إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة”؟ فهل بعد النص الدستوري من حاجة لإعادة تدقيق تلك الأحكام من لجنة قضائية ستصل في المؤدى لنفس النتيجة، ولكن بعد سنوات طوال باعتبار أن عدد ملفات تلك المحكمة يتجاوز مئة ألف ملف وحكم.
إذا كان النص الدستوري قرر “إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب”، فهذا يعني سقوط تلك الأحكام واعتبارها معدومة بالضرورة، ولا يجوز لأي جهة أو لجنة أو محكمة مراجعتها أو إعادة النظر فيها مجددًا لأنها هي والعدم سواء. والأمر لا يستلزم إلا قرارًا أو تعميمًا من الوزير إلى جميع الجهات الرسمية ذات الصلة بإلغاء أي تعميم أمني أو إجراء تحفظي اتخذ بناء على تلك الأحكام، ورفعها من السجلات الرسمية والصحائف العقارية والممتلكات الخاصة بالمحكومين أو الملاحقين، ودون أن يرتب ذلك عليهم أي التزامات أو أداءات مالية لترقينها.
المؤسف أنه في يوم السقوط فتحت أبواب الزنازين على مصراعيها دون رقيب ولا حسيب، فخرج منها معتقلون ومضطهدون ممن ناهضوا النظام وعارضوه، وخرج أيضًا كثير من اللصوص والقتلة والمجرمين والمروجين للمخدرات والخاطفين والمغتصبين، وبينهم من صدرت أحكام جنائية قطعية بحقهم، ومع ذلك لم نرَ أن السلطة الجديدة راجعت ملفاتهم أو حاولت إعادة المحكومين على الأقل إلى السجون.
والمؤسف والأكثر إيلامًا أيضًا أن نرى مرتكبي الجرائم الكبرى ومتزعمي ميليشيات “الدفاع الوطني” وكبار ممولي عمليات قتلنا واستباحة حياتنا، يتجولون بكل صلف ووقاحة بيننا غير عابئين بشيء، لأنهم يدركون أن تلك السلطة، لسبب ما لم نفهمه إلا باعتبارها سلطة، لا تريد محاسبة أحد من المجرمين والقتلة والمأجورين، وعلى المتضررين أن يلوذوا بالصمت والقهر أو فلينطحوا رؤوسهم بأقرب صخرة يجدونها علّ ذلك يخفف ألمهم وخيبتهم.
بينما نرى نفس السلطة تريد إعادة التدقيق في أحكام محكمة “الإرهاب” التي لم يُحل إليها سوى خصوم النظام السابق ومعارضيه، للتثبت من مخالفتها للمعايير القانونية، قبل أن تقوم بإلغائها!
الحكومة التي لا تتبع الأصول القانونية في التفتيش والاعتقال والتحقيق، وتقتحم البيوت بلا إذن قضائي، وتعتقل دون أمر قضائي وتمارس العنف والتعذيب كوسيلة من وسائل التحقيق، هي نفس الحكومة التي تنكر العدالة عندما يمتنع رؤساء أقسام شرطة ومحامون عامون عن قبول شكاوى مواطنين على أشخاص من منظومة الإجرام السابقة، دون تفسير مفهوم لهذا الرفض، وهي نفس الحكومة التي صمتت على منع محاميات من مرافقة موكليهم من الذكور إلى بعض الدوائر الرسمية لأنها ارتأت تطبيق مفهوم الفصل بين الجنسين، وهي نفس الحكومة التي تنتهك الإعلان الدستوري الذي ألغى مفاعيل الأحكام الصادرة عن محكمة “الإرهاب”، وتريد الآن التدقيق في ملفات المحكومين من تلك المحكمة قبل أن ترفع الحيف عنهم، فنحن، إرهابيون إلى أن تثبت لجنة وزير العدل خلاف ذلك، وربما لا تثبت!
————————-
العدالة المؤجلة.. كيف تصنع الدولة قنابلها بيدها؟/ بتول الشيخ
18 أبريل 2025
هل طُوي ملف العدالة الانتقالية ورُمي في غياهب النسيان، بذرائعٍ أكبرها مخفيّ، وأقلها المصالحات والتسويّة؟
في مشهد يبدو للوهلة الأولى كاريكاتوريًا، مع أنه واقعي حتى العظم، يعود ضباط النظام السابق إلى منازلهم، فتُحذف الأدلة ويُغلَق الملف على حساب جروحٍ مفتوحة.
قضيتان حديثتان – إحداهما من حمص والثانية من اللاذقية – تكشفان كيف أن الحكومة السورية الجديدة، رغم كل الشعارات، ما زالت تغضّ النظر عن المجرمين.
في حمص، أُخلي سبيل اللواء محمود يونس عمار، رغم اعترافه العلني والموثّق بضلوعه في النصب على ذوي المعتقلين. لا محاكمة، لا استدعاء شهود، لا تحقيق، ولا حتى مجرد اعتذار.
تزامن هذا مع رفض شكوى لوالد أحد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الدفاع الوطني. فمن يستطيع محاسبة “حمامة السلام” فادي صقر وهي تحلق في سماء السلم الأهلي؟ تُرفض الشكوى رغم وجود صور للضحايا بحجة غياب الأدلة. وهنا نسأل: إذا لم تكن الصور دليلًا فماذا تكون الأدلة إذن؟ وإن كان الجلّاد يُكرَّم باسم المصالحة، ويُمنح منابر للحديث عن “تعزيز الثقة المجتمعية”، بينما تُطالب الضحية بـ”النضج” و”عدم إحياء الماضي”، فأين تُدفن العدالة؟ أم أنها، هي الأخرى، دُفنت في إحدى مقابر النجاة الوطنية بصمتٍ تام؟
الآن سيخرج صوت يقول لنا: السلطات تعرف ماذا تفعل. السلطات تملك خطة بالطبع! ولهذا الصوت بالذات، دعنا نناقش الواقعة بحياد: ضابط أمن اعترف صراحة بالنصب على أهالي ضحايا التعذيب، أُخلي سبيله من قِبل قاضية لم تفتح تحقيقًا، ولم تسمع رواية الأهالي، ولم تواجهه بأي مساءلة. والنتيجة؟ الضحية تُنسى، والجلاد يُسامَح.. رسميًا.
قانونيًا، قرار إخلاء السبيل يفتقر لأدنى درجات المساءلة. نحن لا نتحدث عن تهم سياسية فضفاضة، بل عن اعتراف جنائي واضح لم يلق أي تبعات. كيف يمكن لمؤسسة قضائية أن تتعامل مع الجريمة كمجرد سلوك عابر؟
أما في قضية فادي صقر فالموضوع ذاته يتكرر: تم تهميش الأدلة، بل والسخرية الضمنية من فكرة الملاحقة. وفوقها الدستور الذي يُفترض أنه يجرم كل من تلطخت يده بدماء السوريين.
سياسيًا، إذا كانت الدولة تسعى لتقديم نفسها كراعية للسلم الأهلي، فإن تبييض وجوه الجلادين ينسف هذا الخطاب من جذوره. كيف يُفترض بالضحايا أن يصدقوا نوايا الدولة بينما من أذاهم يلبس عباءة السلام؟ المصالحة تُفرض، لا تُبنى، في غياب المساءلة.
أخلاقيًا، طلب التسامح قبل الاعتراف جريمة مضاعفة. تبييض الجلاد أمام الكاميرات بينما الضحية تُطالب بالنضج والتعالي.. هو تواطؤ، لا تعافٍ. وهل من السوي أن نطلب من الضحية أن تكون الأرفع، بينما نكرم قاتلها بحضور رسمي؟
اجتماعيًا، حين يرى الناس أن الجلاد حرّ، وأن الضحية يُطلَب منها “الهدوء”، يفقد المجتمع ثقته بالجميع بالمؤسسات، بالخطاب، وحتى بنفسه. النتيجة ليست فقط إحباطًا، بل انقسام؛ البعض ينسحب، والبعض يدعو للانتقام، والبعض يبدأ بتعميم الحقد. هذه ليست “مصالحة”، بل غليان صامت.
وهنا، أيها الصوت المدافع، اسمح لي بسؤال بسيط: ماذا تظن أن الناس سيفعلون حين تغيب عدالة الدولة؟ بالتأكيد البديل ليس الصمت، بل أخطر ما يمكن أن يولد في الفراغ: عدالة الشارع. فحين يتوقف القانون عن العمل، لا تختفي الأدلة، بل تتحول إلى أدوات انتقام. وتُستخدم الصور والفيديوهات التوثيقية، لا لملاحقة الجناة، بل لإشعال مزيد من الكراهية، لإحياء الأحقاد، ولتأجيج الفوضى. وفي هذا المناخ، لا تتراجع الثقة بالقضاء فحسب، بل يُنظر إلى الحقيقة نفسها كجريمة. تُجرَّم الضحية مرتين: مرة حين يُنكَر ألمها، ومرة حين تُلام على التذكير به.
الرأي العام السوري ليس غافلًا، بل مُنهكٌ من الانتظار والخديعة. يتأرجح بين صوتين يبدوان متناقضين، لكنهما في العمق يُسهمان في النتيجة ذاتها: إسكات صوت الضحايا.
الأول: متفائل أعمى يرى في كل خطوة رسمية “إصلاحًا”، ويخشى أن تُربك العدالة “الاستقرار”.
الثاني: يائس أبكم تعب من التصديق، واختار الصمت كدرع من الخيبة.
وبينهما، ينهض صوت ثالث، لا يصرخ ولا يهمس، بل يرفض الصمت. يقول: العدالة ليست ترفًا، بل شرط بقاء.
ما العمل؟ في زمن الإنكار والتجميل، تصبح العدالة الانتقالية ليست خيارًا حقوقيًا، بل سؤالًا وجوديًا: هل نحن مجتمع قابل لإعادة التكوين، أم مجرد ضحية مؤجلة لانفجار آخر؟
على الإعلام المستقل ألّا يكتفي برصد المأساة، بل أن يصير طرفًا فاعلًا في مساءلة السلطة. وعلى الفاعلين المدنيين أن يرافقوا الضحايا لا أن يتحدثوا باسمهم، وأن يفككوا الرماد لا أن يبيعوا الوهم.
لا يمكن اعتبار الصمت الرسمي فراغًا، إنما هو نوع من السياسة. وما لا يُقال أبلغ مما يُعلن. الرسالة واضحة: لا عدالة في الأفق، ولا حساب في الطريق.
فهل نكتفي بتلقي الرسالة، أم نعيد كتابتها؟ هل نُسكت الجرح ونؤجل الحرية، أم نطالب بها الآن، من موقع أخلاقي لا مساومة فيه؟
لأن كل جلاد يُكرَّم، وكل محكمة تؤجَّل، ليست مجرد خيانة للضحايا، بل قنبلة موقوتة في جسد الدولة. فإما أن نفككها قبل الانفجار.. أو ننتظر بصمتٍ دورنا تحت الركام.
الترا سوريا
——————————-
سوريا اليوم.. يوميات العنف اللغوي في خطاب السلطة الجديدة/ وائل قيس
20 أبريل 2025
في لحظةٍ مفصلية يُعاد فيها رسم ملامح الدولة السورية، تجسّدت أولى صور هذا التحوّل الجذري في سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، بدأت تتشكّل سرديات جديدة ذات طابع شعبوي، تتبناها السلطة الجديدة وأنصارها، وتُستخدم بشكل متزايد بحق من عاشوا في مناطق سيطرة النظام حتى وقت قريب. وبينما كانت التطلعات تتجه نحو بداية مرحلة مدنية ديمقراطية، يجري يوميًا تداول مقاطع مصوّرة في الفضاء الرقمي، تعكس سردية قائمة في المعمعة السورية على الانتقام اللغوي من الآخر منذ سقوط نظام الأسد.
يُغفل أن النسبة الأكبر من السوريين الذين عاشوا في مناطق سيطرة نظام الأسد لـ14 عامًا، نالهم من القمع ما نال غيرهم. لم تكن هناك عائلة لم تُصبها أضرار مباشرة أو غير مباشرة من أفرع النظام الأمنية والعسكرية. ومع ذلك، يطفو على السطح اليوم خطاب سلطوي جديد، يتهم هذه الفئة من السوريين بـ”الصمت” أو “المحاباة”. كما يُنظر إليهم في بعض الأوساط على أنهم فاسدون ضمنًا، تشبّعوا من إرث نظام الأسد، وهو بذلك تناسي لواقع القمع والخوف. هكذا يُراد لإرث المعاناة أن يُمحى، ويُستبدل بصورة نمطية مسبقًا.
أحد أبرز دعائم هذا الخطاب يتمثل في استثمار رمزية القتال الطويل ضد نظام الأسد، الذي خاضته هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة على مدار أكثر من عقد. غير أن هذا الاستثمار تحوّل تدريجيًا إلى أداة لتبرير الإقصاء والتعنيف اللغوي، وذهب إلى إعادة إنتاج القبضة الأمنية بوجه جديد. “اللي بيحرر بقرر”، عبارة طُرحت بكثافة تحذيرات أزمة المناخ العالمية منذ الأيام الأولى لسقوط النظام، وتحوّلت إلى شعار يُرفع في وجه كل من يطالب بمشروع مدني، أو يجرؤ على انتقاد الأداء الإداري أو الأمني للسلطة الجديدة، في مشهد يُعيد التساؤل عن طبيعة “التحرير” ذاته.
وهذا النوع من الخطاب يتغذى على سرديات تُعيد إنتاج نفسها، من خلال عبارات مثل: “وين كنتو الـ14 سنة الماضية؟”، أو “لو كان النظام ما كنتو حكيتو”. وهي تعابير تُحمّل المدنيين مسؤولية صمت مفترض خلال سنوات الحرب، وتُلمّح إلى أن حق التعبير أو النقد يقتصر على من حمل السلاح أو عاش في مناطق المعارضة. في ظل هذا المنطق يُعاد إنتاج ثقافة الإقصاء ذاتها، لكن بأدوات وشعارات جديدة.
لم يعرف التاريخ المعاصر نظامًا أشد وحشية من نظام الأسد الابن. من البراميل المتفجرة إلى المجازر الممنهجة بحق المدنيين، ومن استخدام الأسلحة المحرّمة دوليًا إلى آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، شكّل هذا النظام نموذجًا متطرفًا في القمع والعنف. وتحت أعين الأسد، تحوّلت البلاد إلى شبكة من العشوائيات، ومجتمعات فقيرة منهكة، واقتصاد متهالك. ومع كل هذا، يبرز في المرحلة الجديدة خطاب يتجاهل هذه الخلفية المُثقلة بالألم، معيدًا توزيع الاتهامات على أساس جغرافي.
ويتمثّل الجانب الأخطر في هذا الخطاب بما يرافقه من نزعة تهديدية مباشرة. عبارات من قبيل: “بس لو ما مانعينا نتعرضلكم”، لم تعد مجرّد انفعالات عابرة أو زلات لسان، أو حتى أخطاء فردية، بل أصبحت مؤشر على سردية تكرس عنفًا لغويًا قائم على الانتقام، يحملُ في مضمونه شعورًا دفينًا بالأحقاد، ومرونة مقلقة في تطبيع الإيذاء اللغوي واللفظي معًا. وفي حالات مشابهة تتجاوزها إلى حدود الحريات الشخصية.
ولعل واحدة من تجليات هذه الأحقاد، ما شهدته بعض قرى الساحل السوري من مجازر وعمليات تهجير ونهب استهدفت الطائفة العلوية، في رد انتقامي على سلسلة هجمات شنّتها مجموعات موالية للأسد ضد الأمن العام. هذا التصعيد لم يأتِ من فراغ، بل تغذّى على رواية الانتقام التاريخي، وانفجر في لحظة غياب أي مسار واضح للعدالة أو محاسبة الجناة الحقيقيين.
ما يزيد هذه المخاوف أن بعض هذه الانتهاكات اتخذ طابعًا طائفيًا، مبررًا بانتماء الأسد للطائفة العلوية، وبأن سكان تلك القرى عاشوا في أمان طيلة سنوات الحرب. حتى أولئك الذين لم يخدموا في السلك العسكري، جرى تحميلهم مسؤولية الصمت، باعتباره ذريعة للانتقام. أظهرت الشهادات المصوّرة حجم الفقر المدقع الذي يعيشه سكان ريف الساحل، حيث تعتمد الغالبية على الزراعة كمصدر رزق وحيد، ما يشير إلى أنها نهج قائم على الصورة النمطية.
هذه السرديات تتقاطع بشكل فاضح مع ما وصفه ممدوح عدوان في كتابه الشهير “حيونة الإنسان” حين يُمنح هذا “الإنسان” سلطة مطلقة بلا رقابة. تتكرر جملة من الكتاب على منصات التواصل الاجتماعي، تختصر أصل الحكاية: “إننا نعيش في غابة، والمسافة بين الإنسان والوحش صغيرة لدرجة أن أيًّا منا يمكن أن يكون الضحية أو الجلاد”. صحيح أن الجملة عابرة لكنها مناسبة للحديث عن حالة “الاعتياد”، التي تصب جميع تسمياتها في خانة واحدة: تعويد “الوحش الصغير” على اللجوء إلى العنف اللغوي و/أو اللفظي.
وبالمثل، لا يمكن تجاهل الطابع الشعبوي في هذا الخطاب؛ حيث يتم تبسيط المشهد في ثنائية مُكررة، لكن بمفردات مختلفة: مُحرّر ومخطوف، ثوري وفلول/مكوع. إنها شعبوية مقنّعة تسعى إلى اختزال الظلم على فئة واحدة؛ وفي هذا السياق، تُستخدم اللغة الشعبوية بوصفها أداة هيمنة، وتصبح الكلمات مثل “مُحرر”، “مخطوف”، “فلول” أدوات جاهزة للتصنيف الفوري، حيث تُستبدل بقاموس تعبوي قائم على اصطفاف يتأسس على صورة نمطية مسبقة.
وفي الفضاء الرقمي، تظهر هذه السرديات في حملات التنمر الافتراضي، حيث يُستهدف كل صوت نقدي على وسائل التواصل بحملات تخوين وسخرية وتشويه. هناك من يعتقد أن معركة الحرية انتهت بإسقاط النظام، وأن المطلوب من الجميع هو التصفيق وتبرير الأخطاء. أما من يرفض ذلك، فيُجرد من انتمائه لـ”سوريا الجديدة”، وغيرها من وصفات قاموس اللغة التعبوي.
وفي ظل غياب مسار واضح للعدالة الانتقالية، بمشاركة أممية لضمان الشفافية، تُقدم للمحاكمة الضباط والمسؤولين الكبار في نظام الأسد المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، بالإضافة إلى مرتكبي مجازر الساحل، فإن مخاطر الانزلاق نحو انتقامات عشوائية تزداد. إن تأخير هذه العملية يخلق بيئة فوضوية للعدالة، وهو ما سيؤدي إلى شرخ مجتمعي يهدد السلم الأهلي الهش لدرجة كبيرة، قد يفضي بالبلاد إلى مسارات سوداوية تُفضي في نهاية المطاف إلى الانهيار الكبير.
لقد دفع السوريون ثمنًا باهظًا لإسقاط أحد أعتى الأنظمة وحشية في التاريخ المعاصر، وليس من حق أي فئة أن تصادر هذا الثمن، أو تختزله بأفكار نمطية قائمة على التخوين والنظرة الدونية للآخر/الفرد. تواجه سوريا اليوم، في هذه المرحلة المضطربة من النزاعات الدولية والإقليمية، مصيرًا مجهولًا ومعقّدًا. وفي خضم هذا التحوّل، تتحوّل اللغة إلى أداة انتقامية، مضيفةً إلى أدوات العقاب الجماعي سلاح الكملة.
——————————-
—————————
============================




