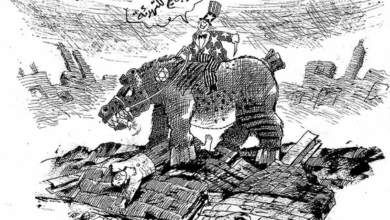سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 23 نيسان 2025

حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
———————————
النظام السوري الجديد الملتبس/ جيروم دريفون
هل تستطيع حكومة الشرع توحيد بلاد على شفا الانفجار؟
الثلاثاء 22 أبريل 2025
المحك الفعلي للنظام الجديد الذي يقوده أحمد الشرع في سوريا يكمن في القدرة على بناء سوريا موحدة وحل الإشكالات مع الأقليات الإثنية والدينية، بما في ذلك التصرف بمنطق الدولة حيال المقتلات التي انفلتت في الساحل السوري ضد العلويين، وينتظر الشعب السوري والدول العربية والغربية نتائج ذلك المحك الذي يعتبر أكثر أهمية من إمكان فرض نظام دولة الحزب الواحد أو التغيير الأيديولوجي والسياسي في تجربة “هيئة تحرير الشام” التي قادها الشرع في إدلب وصولاً إلى إسقاط نظام الأسد.
في أواخر مارس (آذار)، شكل الزعيم الجديد لسوريا أحمد الشرع حكومة تصريف أعمال للإشراف على عملية الانتقال في البلاد بعد خمسة عقود من الحكم الديكتاتوري، ومنح بعض المناصب الوزارية لشخصيات من خارج دائرته الإسلامية، بما في ذلك تعيين امرأة مسيحية وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومسؤول كردي وزيراً للتعليم، ووزير درزي للزراعة، ووزير علوي للنقل. وتعكس هذه التعيينات الضغوط التي يتعرض لها الشرع لإقناع الحكومات العربية والغربية، وكسب ثقة الشعب السوري، بأنه قادر على تشكيل حكومة شاملة تمثل الأقليات الدينية والإثنية في البلاد، وتزداد هذه المهمة صعوبة بعد موجة من سفك الدماء اندلعت في الشهر ذاته عندما استهدف مقاتلون مرتبطون بحكومة الشرع (لكنهم لا يخضعون لإمرتها المباشرة) الأقلية العلوية في غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل المئات.
ومنذ أن اجتاح تنظيم “هيئة تحرير الشام”، الجماعة المتمردة التي يقودها الشرع، شمال غربي سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وأسهم في الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، تطرح القوى الخارجية سؤالاً عن مدى قدرة إسلاموي مثل الشرع على حكم ذلك البلد الكبير والمتنوع. بدعم تركي كانت “هيئة تحرير الشام” تسيطر على محافظة إدلب في شمال غربي البلاد خلال معظم سنوات الحرب الأهلية السورية وتمكنت من توسيع نفوذها في تلك المنطقة، لكن من غير الواضح ما إذا كان ما نجح في إدلب سينجح على نطاق سوريا بأكملها، كما تحيط الشكوك بمدى صدق اعتدال الشرع المعلن أيديولوجياً، فقد بدأت الجماعة كتنظيم جهادي متشدد متحالف مع تنظيم “القاعدة” وتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم “داعش”)، لكن خلال العقد الثاني من القرن الحالي انفصلت الهيئة عن كل من “القاعدة” و”داعش”، وأوضحت أن نضالها محلي ومحصور في سوريا، وبحلول عام 2020 كانت الهيئة تخوض معارك ضارية ضد قوى موالية لـ “القاعدة” و”داعش” في إدلب، وبعد إطاحته بالأسد بادر الشرع إلى التواصل مع الحكومات العربية والغربية، وحرص على تقديم نفسه كقائد معتدل يلتزم بحماية الأقليات الدينية والإثنية في البلاد.
في الوقت الراهن يمسك الشرع بزمام الأمور في دمشق، فالدستور الموقت ينص على أن تستمر الحكومة الانتقالية مدة خمسة أعوام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مما يعني أن الشرع سيبقى في السلطة خلال المستقبل المنظور، وتظل الوزارات الأكثر نفوذاً بيد حلفاء الشرع وهو يتربع على قمة السلطة التنفيذية، وقد أُعلن الدستور الموقت في مارس الماضي، ويتضمن وثيقة حقوق تعترف بحرية المعتقد والرأي والمساواة أمام القانون، لكنه يمنح الشرع صلاحيات واسعة للغاية، إذ سيقوم بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية ويختار ثلث مقاعد البرلمان، في حين تُعين المقاعد الباقية من قبل لجنة عليا يختار أعضاءها بنفسه، ويمكنه في أي وقت إعلان حال الطوارئ وإلغاء ما بقي من القيود المؤسسية الضعيفة على سلطته. يشعر كثير من المسؤولين الغربيين بالقلق من احتمال عودة البلاد لنظام الحزب الواحد، على غرار نظام الأسد، أما كثير من السوريين فيرون في الشرع، وهم على حق، براغماتياً متطرفاً ومستعداً لتقديم التنازلات والتخلي عن التزامات وتحالفات إشكالية، طالما أن ذلك يخدم سعيه الحثيث نحو السلطة.
ولكن لا يبدو أن الأمور تسير نحو عودة سوريا لحكم الفرد المطلق حتى وإن كان ذلك ما يتمناه الشرع في قرارة نفسه، فالنظام الذي يتشكل تحت قيادة الشرع يتضمن عناصر من الحكم السلطوي، إضافة إلى ملامح من تنظيم فدرالي ولا مركزي، ويواجه هذا النظام صعوبات كبيرة في ترسيخ سيطرته على سوريا وكسب تأييد جميع مكونات المجتمع السوري، فقيادة “هيئة تحرير الشام” تُحكم قبضتها على المستويات العليا في وقت تقدم تنازلات لمجموعات أخرى تسعى إلى دمجها في المستويات الدنيا، بما في ذلك الفصائل المسلحة الإثنية التي تسيطر على أجزاء من الجنوب والشرق، وقد بدأت هذه الجهود بالفعل تبلغ حدودها القصوى، إذ تعاني المستويات العليا اختناقاً إدارياً نتيجة تمركز القرار في أيدي عدد محدود من المسؤولين، إضافة إلى توجه انقسامي على الأرض بفعل مقاومة المجموعات المتنافسة لعملية استيعابها في النظام الجديد.
وطالما بقيت مجموعات عدة، مثل الميليشيات الدرزية في الجنوب الغربي والأكراد في الشمال الشرقي، خارج دائرة نفوذ “هيئة تحرير الشام”، فستظل الأخيرة تسيطر جزئياً فقط على سوريا، وفي مرحلة ما سيتعين على الهيئة إما استيعاب هذه المجموعات أو مواجهتها أو القبول الضمني بواقع فعلي لا تمارس فيه السيطرة على كامل الأراضي السورية، وفي حال عزوفها عن التحرك فستغدو مسألة إعادة تركيب الدولة المركزية أمراً مستحيلاً، كما تواجه سوريا مشكلات جدية وخطرة تشمل اقتصادها المنهار وإمكان تجدد الصراع الداخلي والتدخلات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها قوى خارجية، وبالتالي لن تقدر الحكومة الانتقالية على التعامل مع تلك القضايا كلها إذا استمر حال التنازع على السلطة في البلاد.
حلقات السلطة
لقد برهن الشرع و”هيئة تحرير الشام” على قدرتهما على المرونة والتكيف، فعندما سيطرت الهيئة على إدلب عام 2019 لم تكتف برفض تنظيميْ “القاعدة” و”داعش”، بل تخلت كذلك عن الجهادية والسلفية بشكل عام، واصطفت إلى جانب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي الذي يحظى بشعبية في أوساط السكان المحليين، كما تصالحت مع الصوفيين الذين كانت الهيئة في أشكالها السابقة تعتبرهم خصوماً، وتخلت الهيئة عن هدفها العلني السابق في تصحيح عقائد الناس وتنازلت عن كثير من معتقداتها الأيديولوجية وأطروحاتها السياسية، فعلى سبيل المثال قررت “الهيئة” العام الماضي تجميد قانون “الأمر بالمعروف” الذي اقترحه المحافظون في إدلب، والذي كان يفرض الفصل الصارم بين الجنسين في معظم الأماكن العامة ويقيد عدداً من المسائل الثقافية، بما في ذلك الموسيقى ولباس النساء والمثلية الجنسية، وفي يونيو (حزيران) 2020 شنت “الهيئة” حملة قمع ضد تنظيم “القاعدة” في إدلب بالتزامن مع حرب شاملة ضد تنظيم “داعش”.
انبثقت هذه المقاربة من تقييم واقعي لموقع “الهيئة” في أواخر العقد الثاني من الألفية، فقد أدركت أنها لا تمتلك الكوادر الكافية لإدارة إدلب بفعالية، واضطرت إلى استمالة الغالبية الصامتة من المسلمين في المنطقة، أولئك الذين لا يدينون بالولاء القوي لأية جهة فاعلة، ويرجح أنهم يرفضون مواقف الهيئة الأيديولوجية الأكثر تشدداً، وقد عززت “الهيئة” سيطرتها على إدلب من خلال تقديم نفسها كبديل عن المتشددين مثل “القاعدة” و”تنظيم الدولة الإسلامية”، وكذلك عن نظام الأسد، وبهذا ضاقت المساحة أمام القوى السياسية المنافسة.
عملياً واصلت الهيئة تفويض جزء كبير من شؤون الحكم في إدلب، بما في ذلك قطاعات مثل التعليم والصحة، إلى أطراف ثالثة مثل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، ولم تسمح بأية معارضة سياسية منظمة أو انتقادات لهيمنتها السياسية في المحافظة، لكن بحلول عام 2024 شعرت بالثقة الكافية في موقعها في إدلب، مما دفعها إلى تخفيف بعض مظاهر سيطرتها السلطوية، فأتاحت المجال أمام بعض منظمات المجتمع المدني ووسعت قاعدة التمثيل في البرلمان المحلي، وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية اجتاحت المحافظة، وقد أظهر الشرع فطنة سياسية حين أدرك أن بقاء مجموعته يتطلب مزيجاً من الإبقاء على قبضته السياسية المحكمة وفتح هامش محدود وغير مهدد لحكمه أمام الأصوات المعارضة والبديلة.
شكلت تجربة إدلب نموذجاً اعتمد عليه الشرع في توسيع مشروعه، لكن حكم سوريا من دمشق ليس كحكم إدلب، وكما في إدلب لا يمكن لـ “الهيئة” أن تعتمد على كوادرها وحدهم في حكم البلاد، فالدولة أكبر بكثير وأشد تنوعاً من تلك المحافظة، وللحفاظ على السيطرة تحتاج الحكومة الجديدة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الدول الأجنبية من أجل الحصول على دعم دبلوماسي، بخاصة في ما يتعلق برفع العقوبات، وكذلك على الدعم المالي والاقتصادي من دول الخليج والغرب لإعادة بناء البيروقراطية وتمويل الجيش، كما لا يمكن للحكومة الجديدة فرض رؤيتها بصورة أحادية في كثير من المناطق، ولا سيما تلك التي لا تزال المجموعات المسلحة الأخرى تملك نفوذاً فيها، وتضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات تحت ضغط المعارضة المحلية، وعلى رغم أن حلفاء سوريا من دول الخليج والغرب قد لا يطالبون بإرساء ديمقراطية حقيقية، فإنهم يتوقعون من دمشق أن تضمن قدراً من الشمولية في التمثيل والمشاركة السياسية.
تعمل “هيئة تحرير الشام” من خلال دوائر متعددة للسلطة، وفي مركزها يعتمد الشرع على مجموعته وشبكة من المقربين الموثوقين للإشراف على الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، وتشمل الدائرة الثانية قادة إسلاميين مخضرمين وشخصيات مؤثرة ذات خبرة في الحكم في إدلب لا ينتمون رسمياً إلى “الهيئة” لكنهم يضطلعون بأدوار محورية في إدارة الإدارة المدنية، أما الدائرة الثالثة فتضم أفراداً من ميليشيات سورية مدعومة من تركيا تنضوي تحت لواء “الجيش الوطني السوري”، وقد بقيت هذه المجموعات خارج سيطرة الحكومة على رغم المحاولات الرامية إلى دمجها ضمن وزارة الدفاع الجديدة، وتشكل الدائرة الرابعة المجتمعات العربية السنيّة التي تسعى الهيئة إلى تحويلها إلى قاعدة دعم موثوقة للنظام الجديد.
وقد نظمت الحكومة الموقتة مؤتمراً لـ “الحوار الوطني” في أواخر فبراير (شباط) الماضي دعت إليه كثيراً من الشخصيات البارزة والمعارضة في محاولة لتوسيع القاعدة الاجتماعية للنظام الحاكم الجديد، وقد ساعد هذا المنتدى في منح حكومة شرع الانتقالية غطاء من الشرعية، كما مكن من إدماج أطراف هامشية ربما كانت لتظل على الهامش وتتصرف كقوى معرقلة، غير أن هذا النهج يوشك أن يبلغ حدوده، فاعتماد الشرع على شبكة ضيقة من المستشارين المقربين أدى إلى تركيز مفرط في صنع القرار، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية النظام ويكشف ضعفاً في قدراته المؤسسية، كما أن هيمنة أعضاء الهيئة وحلفاءها الإسلاميين على الحكومة الحالية فاقم المخاوف لدى كثير من السوريين من “أدلبة” الدولة، أي نقل بيئة إدلب المحافظة والسنيّة والثورية المناهضة للأسد إلى فسيفساء دمشق المتنوعة.
وفي الوقت ذاته بدأت مجموعات أخرى أقل قرباً من “الهيئة” تبتعد منها، فبعض الفصائل التي تملك نفوذاً سياسياً وعسكرياً يمكنها من فرض شكل من أشكال الحكم الذاتي، مثل بعض الفصائل الدرزية في الجنوب، أو جماعة “جيش الإسلام” السلفية السنيّة التي تحاول بناء جهاز مدني – عسكري خاص بها في ضواحي العاصمة، ترفض عروض الدخول في النظام الجديد، وتبدو المسافة عن الدولة أوضح في حال “قوات سوريا الديمقراطية” بقيادة الأكراد في الشمال الشرقي، فالقوات التي تسيطر على منطقة واسعة ذات حكم شبه ذاتي على الحدود مع تركيا والعراق وافقت اسمياً على الاندماج ضمن وزارة الدفاع لكنها تركت تفاصيل هذا الاندماج غامضة، وقدمت مطالب عدة تتعلق بالدستور المرتقب وضمانات لحقوق الأقليات والحفاظ على بعض مظاهر الاستقلال العسكري.
ما يتشكل ليس دولة الحزب الواحد، خصوصاً وأن “هيئة تحرير الشام” لا تملك من القوة ما يؤهلها لإنشاء مثل هذا النظام، بل نظام سلطوي هجين وأكثر تعقيداً. في هذا النظام تحتفظ الهيئة بالمواقع الأكثر نفوذاً بينما تفوض أدواراً أقل أهمية لجهات أخرى، ويسيطر الشرع وحلفاؤه إلى حد كبير على أهم الوزارات، الخارجية والدفاع والداخلية والمجلس الأعلى للأمن الوطني الذي أُنشئ حديثاً – فيما يلعب الوزراء من خارج الهيئة أدواراً ثانوية فقط، ويبقى أن نرى مدى تبرم أولئك الشركاء من هذه الترتيبات ومتى سيتوقفون عن أداء أدوارهم فيها.
لا وقت نضيعه
للأسف سوريا بحاجة ماسة إلى حكومة مستقرة وكفؤة، فهي تواجه تهديدات آنية عدة، فالوضع الاقتصادي لملايين السوريين كارثي والبلاد تقف على حافة الانهيار، ووفقاً للأمم المتحدة فإن الاقتصاد إذا استمر على مساره الحالي فلن يعود لمستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت قائمة قبل اندلاع الصراع إلا بعد نحو ستة عقود، ومن دون مساعدات اقتصادية عاجلة، ولا سيما من خلال تخفيف العقوبات التي فرضتها القوى الخارجية على نظام الأسد، فمن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مما يصعب على الحكومة الجديدة بناء جهاز بيروقراطي وأمني فعاليْن.
علّق الاتحاد الأوروبي عدداً من العقوبات في قطاعات الطاقة والنقل والمصارف، ومدد الاستثناءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى، إلا أن سوريا لا تزال خاضعة لعقوبات مشددة من جانب الولايات المتحدة، وبسبب مركزية المؤسسات المالية الأميركية في الأسواق العالمية، على رغم محاولات إدارة ترمب الحالية إعادة توجيه الاقتصاد العالمي، فإن من غير المرجح أن تقوم دول كبرى أو جهات خاصة باستثمارات كبيرة في البلاد ما لم يتغير الموقف الأميركي.
وكذلك يجب على الشرع التعامل بجدية مع تداعيات أعمال القتل الطائفية التي جرت في مارس الماضي في القرى العلوية على امتداد الساحل السوري، فقد كان الأسد ينتمي إلى الطائفة العلوية وكان يتمتع بدعم قوي منها، وبعد معارك مع فلول تابعة للنظام شنت مجموعات مسلحة تابعة اسمياً لوزارة الدفاع في حكومة الشرع، لكنها تعمل باستقلال عنها، إضافة إلى مقاتلين أجانب وميليشيات محلية، هجمات على المناطق العلوية، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل ما يصل إلى 1000 شخص بينهم مدنيون وعناصر من القوى الأمنية ومتمردون، كما وثقت منظمات حقوقية تنفيذ عمليات إعدام تعسفية بحق مدنيين علويين على أيدي مقاتلين محسوبين على الحكومة.
ويثير هذا الوضع قلقاً بالغاً نظراً إلى تصاعد الطائفية بين بعض المجتمعات السنيّة في وسط سوريا وساحلها مع تنامي الدعوات إلى الانتقام من العلويين، وقد يكون لهذا التوتر الطائفي تبعات خطرة على الشرع، إذ قد تتردد القوى الخارجية في مساعدة الحكومة الجديدة إذا ما ساورها الشك في قدرتها على منع العنف المجتمعي، وحتى الآن استُبعد العلويون إلى حد كبير من الهياكل السياسية والأمنية، وقد يفاقم هذا التهميش خطر اندلاع تمرد تقوده عناصر أمنية سابقة من النظام وأفراد من الطائفة العلوية، مما يهدد استقرار جهود الحكومة الجديدة في تهدئة الأوضاع.
عيّن الشرع لجنة للتحقيق في عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عنها، وتراقب دول عدة في الخليج والغرب مجريات الأمور عن كثب، ويمكن لعملية شفافة وواضحة، تعالج عمليات القتل وتطمئن العلويين، أن تبعث برسالة إيجابية إلى الخارج في شأن نيات الحكومة الجديدة وقدرتها على إعادة بناء سوريا موحدة، أما الفشل في التحرك أو تكرار ما جرى على الساحل خلال مارس الماضي فقد يشعل دوامات جديدة من العنف ويقوض الثقة في الشرع، وفي تلك الحال ستصبح القوى الخارجية أقل استعداداً لتخفيف عبء العقوبات على سوريا، وستتعمق الأزمة حتماً مصحوبة بتفجر التوترات الاجتماعية والعنف، وبدلاً من أن يبشر الشرع بفجر جديد لسوريا، سيكون قد مهد الطريق لليل آخر من اللايقين.
مترجم عن “فورين أفيرز” مارس (آذار)/ أبريل (نيسان) 2025
جيروم دريفون، محلل رفيع في شؤون الجهاد والصراعات المعاصرة ضمن “مجموعة الأزمات الدولية”، وألّف كتاب “من الجهاد إلى السياسات، كيف احتضن جهاديو سوريا السياسة؟”، وشارك في تأليف كتاب يظهر قريباً بعنوان “تغير تحت تأثير الشعب، “هيئة تحرير الشام” والطريق إلى السلطة في سوريا”.
—————————-
«هذا البيت لي»: وثائق الملكية المفقودة تُؤخّر عودة سكان مخيم اليرموك/ المعتصم خلف
21-04-2025
منذ سقوط حكم نظام الأسد، تسعى العائلات للعودة إلى ممتلكاتها في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، وهي عودة غير مكتملة بسبب حجم الدمار الهائل الذي طال 60% من أبنية المخيم. تحفّ بهذه العودة تساؤلات عديدة، وقد وجدت بعض العائلات إجاباتها ما سمح لها ببدء ترميم منازلها، في حين اضطرت عائلات أخرى للعودة إلى منازلها المتهالكة دون ترميم بسبب الإيجارات المرتفعة التي يدفعونها شهرياً خارج المخيم.
لكن سؤال العودة بقي بلا إجابات بالنسبة للعائلات التي فقدت الأوراق الرسمية التي تُثبت ملكيتها في المخيم، وبين احتمالات العودة وصعوباتها، نحاول في هذا التقرير طرح الأسئلة الرئيسية المتعلقة بقضية فقدان أوراق توثيق الملكيات العقارية: ما هي أنواع التوثيق العقاري للفلسطينيين ضمن مخيم اليرموك؟ وما واقع العائلات التي فقدت أوراقها الثبوتية؟ وما طبيعة الحلول القانونية المتاحة؟
ملكية ضائعة وعودة مستحيلة
الأبنية التي تحوّلت إلى تلالٍ من الركام في المخيم ما تزال تحمل أسماءها. بعد التلة الكبيرة لمستشفى فلسطين، باتجاه حي التقدّم، يقع بيت أم ياسر؛ بناءٌ كان من طابقين، لم يتبقَّ منه إلّا الطابق الأرضي. وقفت أم ياسر وزوجها أمام بابٍ مخلوع، تسدُّ عتبته كتل الركام، وأشارت قائلة: «هذا هو بيتنا».
أُضيئت بعض البيوت في الحي بأضواء «الليدات» الخافتة بعد عمليات ترميم سريعة، لكن عائلة أم ياسر لا يمكنها العودة، بسبب فقدانها الأوراق التي تثبت ملكيتها للمنزل. عائلات كثيرة جداً في مخيم اليرموك فقدت أوراقها الثبوتية وسجلاتها العقارية بسبب موجات النزوح الجماعي المتكرّرة، وأبرزها يوم النزوح الكبير في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2012، إضافةً إلى استراتيجيات الحصار والقصف الوحشي الممنهج اللاحقة التي انتهت بعمليات نهبٍ وحرق للممتلكات.
تقع المنازل والأبنية السكنية في مخيم اليرموك على مساحات واسعة غير مفرزة، تُقدَّر بحوالي كيلومترين مربعين. وتنقسم الأراضي التي أُقيم عليها المخيم بشكل رئيسي إلى قسمين: الأول هو الأراضي التي استأجرتها المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الداخلية، ووزّعتها على اللاجئين للبناء، والتي تمتد ضمن ما يُعرف بـ«المخيم القديم»، وهي المساحة الممتدة من مدخلَي مخيمي اليرموك وفلسطين وصولاً إلى شارع المدارس. أما القسم الثاني فهو الأراضي الخاصة بعائلتي الحكيم والمهايني، التي توسع المخيم تدريجياً إليها.
يخضع استملاك العقارات بالنسبة للفلسطينيين السوريين لتشريعين رئيسييين في القانون السوري، حدَّدا أساليب البيع والشراء ونقل الملكية العقارية بالنسبة لهم. القانون الأول هو القانون رقم 260 الصادر عام 1956، والذي منح الفلسطينيين حق تملك عقار واحد لكلٍّ من اللاجئ وزوجته وأولاده القُصَّر. أما القانون الثاني، فهو القانون رقم 11 لعام 2011، الخاص بتملّك الأجانب والعرب للعقارات، والذي اشترطَ الحصول على موافقة من وزارة الداخلية وأخرى أمنية. ومن شروط التملّك أن يكون العقار مُفرزاً، أي «طابو أخضر» وفق التعبير الشائع شعبياً، وهو أمر نادرٌ في المخيم نظراً إلى أنه بُني على أراضٍ مملوكة على الشيوع بمساحات كبيرة. كما أشرنا أعلاه.
مع مرور الزمن، تضاعفت أعداد المالكين نتيجة ازدياد الارتفاع الطابقي للأبنية، ما جعل عملية الفرز أكثر تعقيداً، فضلاً عن تكلفتها الباهظة وحاجتها إلى صدور قرارات ومخططات تنظيمية. وهكذا يلجأ سكان المخيم، كما كثير من مناطق السكن الشعبية في محيط العاصمة وغيرها من المدن، إلى توثيق ممتلكاتهم العقارية بطرق أخرى مثل «وكالة الكاتب بالعدل» و«حكم المحكمة».
يُعتبر التوثيق بـ«الطابو الأخضر» نادراً جداً في المخيم، وهو الأكثر قوةً وأماناً، لأنه يعني أن العقار له صحيفة عقارية في السجل العقاري تتضمن كامل معلوماته. يقتصر «الطابو الأخضر» في مخيم اليرموك على بعض العقارات في شارع 30، بالإضافة إلى المشروع السكني الذي أنشأته محافظة دمشق غرب مخيم اليرموك، خلف جامع الوسيم بالقرب من شارع لوبية وساحة الريجة، لتوفير سكن بديل للمتضررين من توسعة الطرق في مناطق دمشق مثل نهر عيشة، الذين يمكنهم اليوم العودة إلى أملاكهم باعتبارها محمية في السجل العقاري.
أما «وكالة كاتب العدل» فهي تتم عن طريق وكالة خاصة «غير قابلة للعزل لتعلَّق حق المالك بها» حسب التعبير القانوني. وينقسم كل عقار مهما كان نوعه في سوريا قانونياً إلى 2400 سهم، وعندما يتم إنشاء أبنية وبيوت على أراض ضخمة غير مفرزة، يتم توثيق ملكية كل شخص عبر بيعه عدداً من هذه الأسهم بما يكافئ البيت الذي يشتريه. عند الكاتب بالعدل، يتم توثيق البيع عبر توكيل المشتري وكالة نهائية لا رجعة عنها بالتصرف في حصة سهمية من العقار غير المُفرَز؛ مثلاً: «الحصة السهمية المُقدّرة بـ5.3 سهماً من العقار رقم 89 من منطقة كذا، وهذه الأسهم تُشكّل الشقة السكنية الجنوبية الغربية من الطابق الثاني من البناء المشيَّد على العقار، بموجب رخصة البناء رقم كذا لعام كذا».
أما عمليات البيع والتوثيق العقاري بموجب «حكم محكمة» فهي تتم من خلال رفع دعوى تثبيت بيع أمام المحكمة المختصة. وتقوم المحكمة بإجراء كشف حسي على العقار، ثم يَصدرُ حكم بتثبيت البيع، بعد أن يتم وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية للعقار الكبير غير المفرز الذي بُني البيت عليه. ويُعتبر هذا النوع من التوثيق دليلاً قانونياً قوياً، إذ إن مالك العقار في هذه الحالة يحوز حكماً مكتسباً للدرجة القطعية ومبرماً من المحكمة المختصة التي يتبع لها موقع العقار، وإن كان لا يملك سجلاً عقارياً لبيته نتيجة عدم إفرازه كعقار مستقلّ.
صورة عن حكم محكمة بتثبيت ملكية عقارية
على الرغم من أن حكم المحكمة يُعدّ في المرتبة الثانية من حيث القوة القانونية بعد «الطابو الأخضر»، فإن معظم سكان مخيم اليرموك اختاروا توثيق ممتلكاتهم عبر كاتب العدل، نظراً لسهولة الإجراءات وسرعتها وانخفاض تكلفتها مقارنة بالإجراءات القضائية. ورغم ما يتمتع به حكم المحكمة من قوة توثيقية، ونجاة معظم هذه الأحكام من التخريب الذي طال مستودعات الوثائق في مدينة دمشق، إلا أن المالكين الراغبين في العودة إلى المخيم بعد فقدانهم لوثائقهم الأصلية، يُطلب منهم توفير نسخة من الحكم القضائي على الأقل. في هذا السياق، يشير المحامي رامي جلبوط إلى أهمية الاحتفاظ بهذه النسخة: «على الأقل، نحن بحاجة إلى نسخة من الحكم حتى نعرف رقم القرار وتاريخه والمحكمة التي أصدرته، لنتمكن من استخراج نسخة حديثة عنه. وإذا كان المالك قد فقد معلومات القرار بالكامل، يصبح الأمر شبه مستحيل، ويستلزم جهداً كبيراً وبحثاً طويلاً لمعرفة رقم القرار وتاريخه والمحكمة المُصدِرة له».
اعتاد سكان مخيم اليرموك على توثيق وكالاتهم ضمن مكتب دائرة كاتب عدل المخيم، بينما لجأ قسمٌ كبير منهم إلى توثيقها لدى أي كاتب عدل قريب أو متاح خارج المخيم، في مناطق مثل الحجر الأسود أو داريا. أغلب هذه الدوائر التي كانت تحوي آلاف السجلات دُمّرت بالكامل. بدأ أثر هذا التدمير بالظهور بعد سقوط نظام الأسد، مع محاولات العائلات العودة إلى ممتلكاتها.
تقف أم ياسر اليوم أمام منزلها دون أي وثيقة قانونية تثبت ملكيته، بعدما تعرّضت دائرة كاتب العدل التي سُجّل فيها العقار في الحجر الأسود للتدمير. عن هذه المشكلة تقول أم ياسر: «أنا هلأ عندي بيت وما عندي بيت، وما في أي ضمانات قانونية تضمن لي أنه إذا رممناه ما نتعرض للطرد. لهيك، كل اللي قدرنا نعمله أنا وعائلتي لحدّ هلأ هو أننا نحصل على وثيقة من المختار، تشهد بأننا أصحاب العقار بشهادة الجيران، حتى نقدر نوفر شوية مصاري كرمال نوكّل محامي ونشوف شو فينا نعمل».
تنتشر اليوم على بعض جدران منازل مخيم اليرموك عبارات تحذيرية لمنع التعدي على الممتلكات، مرفقةً بأسماء مالكي الأبنية والمنازل، إلى جانب أرقام المحامين الذين يعملون على قضايا إثبات الملكية. تُعَدّ هذه الخطوة مكلفة بالنسبة لمعظم العائلات، إذ تتراوح تكلفة استشارة المحامي بين 50 ألفاً و250 ألف ليرة سورية، بينما لا تقلّ كلفة الإجراءات القانونية أمام القضاء عن مليوني ليرة، وقد تصل إلى 15 مليون ليرة سورية.
أمام هذه التكلفة الباهظة، تواجه عائلة أم ياسر أسئلة مصيرية حول قدرتها على العودة إلى مخيم اليرموك، وسط جهود شخصية ومادية تحاول تحمّل أعبائها. تقول أم ياسر: «سقوط بشار الأسد أعطانا أمل لنقدر نرجع على بيوتنا، بس هاد الأمل ما طلع كافي، لأنو تأثير النظام بحياتنا بعده موجود. البيت مهدّم، والحياة صعبة وغالية. وبالظروف الحالية، المطلوب نعمله لنرجع على بيوتنا أكبر من قدرتنا، ويلي بدنا ياه أنو ما ندفع ثمن أكبر ونخسر بيوتنا يلي تهجّرنا منها».
أفق الحلول القانونية الممكنة وصعوباتها
حتى اليوم، لا يوجد أي سياق قانوني مُحدَّد وواضح يمكن من خلاله للعائلات استعادة أملاكها العقارية في المخيم. ومع ذلك، يحاول المحامون المراجعة والبحث ضمن تسلسل الوكالات التي تم من خلالها إجراء عمليات البيع، أو غيرها من الوثائق المتاحة.
تبدأ العملية بتحديد نوع الأرض التي يقع عليها العقار، سواء كانت ضمن الأراضي الخاصة بعائلتي الحكيم أو المهايني أو غيرهم من مالكين آخرين لمساحات أقل، أو أراضي الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، وذلك لتحديد آلية البحث عن الوثائق وطرق تثبيتها للمالكين مجدداً. يبدأ المحامون البحث عن إذن السكن الأساسي في حال كانت الأرض مملوكة للهيئة العامة للاجئين، وفي حال كان صاحب الإذن لا يزال على قيد الحياة، تتم المتابعة معه حتى الوصول إلى المشتري الأخير للعقار لتوثيقه. أما إذا كان غير موجود، فيتم البحث عن ورثته.
يُعدّ هذا النوع من الحلول من الأصعب، إذ يعتمد بشكل أساسي على تتبع الورثة، الذين قد يكونوا مسافرين، مهجرين، متوفين، أو غير متفقين فيما بينهم، مما قد يدفع المشترين الأخيرين إلى دفع رشاوى مالية للورثة مقابل إتمام إجراءات نقل الأملاك العقارية مجدداً، وهي ممارسة شائعة في مخيم اليرموك. عن محاولة توثيق سلسلة الوكالات وصولاً إلى المالك الأخير يقول المحامي رامي جلبوط: «قضايا إثبات الملكية بالنسبة للعائلات التي خسرت وثائق ملكيتها خلال الحرب من أصعب وأعقد القضايا اليوم، لأنها تعتمد على بحث مُضنٍ لا نعرف من أين يجب أن يبدأ لنصل إلى نتائج، خاصة أن ‘الطابو الأخضر’ نادرٌ جداً في المخيم. ويوجد طرق متعددة لتوثيق الممتلكات، مثل حكم المحكمة، العقود، أحكام تثبيت صحة بصمة والتوقيع، بالإضافة لوكالات الكاتب بالعدل التي تَعرَّضَ أغلبها للتدمير والحرق. وحتى بالنسبة العائلات التي قامت بتوثيق ممتلكاتها لدى مكتب كاتب بالعدل لم يتعرض للتدمير، مثل كاتب عدل منطقة ببيلا، فيجب على الأقل أن تمتلك العائلة رقم الوكالة العام والخاص والسجل، لأنه من شبه المستحيل البحث ضمن عشرات آلاف السجلات».
في مثال يوضح طبيعة عمليات البحث التي يُجريها المحامون لإثبات حق الملكية، تظهر في الصورة مخالفة بناء تعود لعام 1981، وتشمل منازل في الطابقين الأول والثاني ضمن أحد العقارات الواقعة في مخيم اليرموك. هذه الوثيقة تُعدّ الوحيدة التي تحتفظ بها العائلة بعد فقدانها لكافة الوثائق والأوراق التي تُثبت ملكيتها للعقار، ويُركّز المحامي رامي في بحثه ضمن هذه الوثيقة على الوكالة الأساسية التي تم بموجبها ترخيص البناء. بعد أكثر من شهر من البحث المضني، يبدأ الاستدلال على وجود الوكالة من خلال علامات مميزة ضمن البناء. ففي هذه الحالة، كان العقار يحتوي على مطعم، مما دفع المحامي للبحث عن التكليف الضريبي المتعلق بالمطعم باعتباره وسيلة للوصول إلى معلومات تُشير إلى وكالة البائع الأساسي للعقار.
أما في حالات العقارات الواقعة على أراضٍ مملوكة للدولة، وهي حالات نادرة جداً في مخيم اليرموك، فإن عملية توثيق ملكية العقار غالباً ما تعتمد على فواتير الماء والكهرباء. وعلى الرغم من أن فاتورة الماء أو الكهرباء لا تُعدّ مستنداً قانونياً مُعترفاً به في المحاكم لإثبات الملكية، فإنها تُستخدَم في بعض الأحيان كوسيلة للاستدلال على وجود إشغال فعلي للعقار من قبل المالك. كما يمكن أن توفر هذه الفواتير معلومات مساعدة تُسهم في تسهيل عملية البحث عن وثائق أو بيانات داعمة لتأكيد الملكية.
بالإضافة إلى صعوبات البحث القانوني، يعاني المحامون من آثار تزوير أزلام النظام السابق لوثائق ممتلكات المعارضين. بعد عام 2018 شهدت سوريا تحولات سياسية وعسكرية استعاد فيها نظام الأسد السيطرة على معظم الأراضي بفضل الدعم الروسي والإيراني، ما أدى إلى موجة نزوح وتهجير قسري ضمن الغوطة الشرقية وجنوب سوريا وفي مخيم اليرموك عبر باصات خضراء إلى إدلب.
استغلّ أزلام النظام حالة الإفراغ التي شهدتها المناطق التي تعرّضت لعمليات عسكرية، حيث تم الاستيلاء على عدد من العقارات من خلال عقود مزوّرة. ولفهم آلية هذا التزوير، لا بد من طرح سؤال جوهري: ما هي العقود؟
تُعدّ العقود من أضعف أشكال التوثيق العقاري، وغالباً ما يتم اللجوء إليها في عمليات البيع والشراء ضمن الأراضي المملوكة للدولة أو في المناطق العشوائية. ويمكن كتابة هذه العقود في أي مكان، بين البائع والمشتري، دون أي إشراف رسمي أو تسجيل في الدوائر العقارية المختصة.
ونظراً لسهولة صياغتها وضعفها القانوني، تُعدّ العقود بيئة خصبة للتزوير، حيث يُمكن تزوير التوقيع أو البصمة بكل بساطة، وهو ما استغله أزلام نظام الأسد للاستحواذ على عقارات في قلب مخيم اليرموك، وبيعها لاحقاً من خلال مستندات وهمية لا تستند إلى أي توثيق قانوني معتمد، إذ يتم رفع دعاوى تثبيت البيع على أساس هذه العقود. من بين المناطق التي شهدت عمليات تزوير مكثفة كانت مخيم اليرموك، حيث استولى أزلام النظام على العقارات من خلال سلسلة من عمليات البيع لضمان ضياع حقوق المالكين. واليوم، تواجه العائلات العائدة إلى ممتلكاتها مالكين جدداً لمنازلهم، ما يضع المحامين في مواجهة مع عمليات تضليل في سلسلة من عمليات البيع والشراء، والتي تتضمن شبكات معقدة من التزوير والرشاوى عمل عليها محامون وقضاة فاسدون مع أعوان النظام السابق، مما يعقد عمل المحامين اليوم أثناء البحث والتقصي لتوثيق الممتلكات العقارية وإعادتها إلى أصحابها.
تواجه سوريا اليوم بشكل عام أزمة فقدان سندات الملكية، يقول المحامي رامي جلبوط: «نحن أمام كارثة، ونحتاج إلى برامج وطنية. حتى بعد سقوط نظام الأسد، لا توجد بيئة آمنة أو مناسبة لعمليات نقل الملكية، لأنه لا يوجد أي ضمان أو توثيق لهذه العملية. حجم التزوير على مستوى سوريا هائل جداً، وهذا يتطلب برنامجاً وطنياً تعلنه الدولة السورية. والأهم هو الاستفادة من خبرات دول أخرى، لأن الخبرات الحالية غير قادرة على الإحاطة بحجم الكارثة».
موقع الجمهورية
———————————
الصورة الغائبة: دولة تُعاد صياغتها بدون النساء/ ميسا صالح
السلطة والعنف الهيكلي والرمزي ضد النساء في سوريا
22-04-2025
منذ اللحظة الأولى، لم تُخفِ السلطة الجديدة في سوريا نواياها: الدولة التي تُبنى على أنقاض سوريا القديمة لا تحتمل النساء، لا كفاعلات، ولا كرموز، ولا كمكوّن عضوي في المستقبل السياسي أو الثقافي. إنها دولة تُعاد هندستها على أجساد النساء المَقصيّات، وعلى أصواتهن المخنوقة، وعلى خضوعهن المُنَظَّم، ليس بوصفه الشرط الوحيد، بل كواحد من الشروط التأسيسية لبناء السلطة.
في هذا المشروع، ليست كراهية النساء نتيجة عَرَضية لتديّن متشدد ورجعي فقط، بل وظيفة بنيوية تُثبّت من خلالها السيطرة؛ كلما تمّ قمع النساء وتقييد حركتهنّ، ازداد تماسك النظام، واشتدَّ ولاء الموالين. إذ تُستخدم النساء كمقاييس للانضباط الاجتماعي، وكحدود أخلاقية يُمكن من خلالها تعريف «الالتزام» و«الرجولة» و«الهوية المجتمعية». تعيدُ السلطة رسم المجال العام بحيث لا تعود النساء حاضرات ومرئيات إلا ضمن حدود الأدوار التي تحددها لهنّ، وبذلك، تُبنى الدولة على تغييب النساء ليس فقط سياسياً، بل رمزياً وسردياً، ويُعاد تعريف «السيادة الذكورية» على أنها الضامن الوحيد للنظام العام.
وهنا، لا يُقدَّم قمع النساء كعنف، بل كفضيلة. تُمارَس الوصاية بوصفها حماية، ويُعاد تعريف الحبس الاجتماعي بأنه صونٌ للكرامة. تُحاصَر النساء بالخطاب الأخلاقي الذي يعيد إنتاج دونيتهن من داخل منظومة القيم، ويُحوِّلهن إلى كائنات تحتاج إلى حماية دائمة، مقابل التنازل الكامل عن فاعليتهن. هكذا، يتحوّل الفضاء العام إلى شبكة من المحرمات: اللباس، الصوت، العمل، الحركة، كلها مشروطة بموافقة النظام الأبوي، سواء جاء على هيئة إمام، أو شيخ، أو شرطي، أو أب، أو موظف دولة.
كراهية النساء كأداة تأسيس، لا كعَرَضٍ ثقافي
منذ أن عُيّنَ أبو محمد الجولاني «رئيساً انتقالياً» بحكم الأمر الواقع، لم تعد السلطة التي يمثلها محصورة في إدلب أو الشمال الغربي، وهي تجربة شديدة «المركزية الذكورية» ومغلقة في وجه النساء؛ بل تحوّلت إلى نموذج مُحتمَل لما يُراد أن يكون عليه «البديل» في سوريا ما بعد الأسد. غير أن هذا النموذج، عوضاً من أن يُبنى على قيم الحرية والمساواة والمشاركة، كونه شكَّلَ لحظة تاريخية لكل السوريات-ين، يُعاد فيه إنتاج بنية سلطوية شديدة «المركزية الذكورية»، تُبنى على كراهية النساء، أحياناً تكون غير مرئية وخفية، وأحياناً فجّة ومباشرة ومدعومة بتشريعات وقرارات، تُقصيهن عن المجال العام، وتمنح الرجال المؤدلَجين حق التشريع والتحكّم والسيادة.
غالباً ما يُختزَل العنف ضد النساء تحت الحكم الديني المتشدد باعتباره «أثراً جانبياً» للتفسيرات المتعصبة، أو امتداداً لثقافة أبوية متوارثة. لكن قراءة متأنية لممارسات السلطة الجديدة في سوريا، تكشف أن كراهية النساء ليست عَرَضاً، بل جزءٌ جوهريٌ من هندسة السلطة نفسها. إنها ليست انزلاقاً أخلاقياً، بل أداة سياسية تستخدم لإعادة هيكلة المجتمع والسيطرة عليه.
تُخبرنا قاضية سورية في شهادة نُشرت مؤخراً على موقع درج أنها باتت تشعر بأن مهنتها كلها، أي القضاء، مهددة بالزوال في ظل السلطة الجديدة، لأن هؤلاء الرجال لا يؤمنون أصلاً بأهلية النساء لممارسة العدالة، ولا يرون أنهن قادرات على الفصل في النزاعات أو اتخاذ القرار القانوني، انطلاقاً من رؤية دينية تُفرغ النساء من فاعليتهنّ السياسية والقانونية.
عندما سَألتْ القاضيةُ عن مستقبل عملهن كان الجواب واضحاً: «هذا القرار متروك للأيام، يوجد مذهبان مختلفان، أحدهما يقول إن المرأة لا تولَّى القضاء نهائياً، والآخر يقول إن المرأة تولَّى القضاء في ما عدا قضاء الحُكم. علينا أن ننتظر ونرى كيف سيصوت مجلس القضاء الأعلى في المستقبل». (تمنع المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة تولية القضاء للمرأة أو لغير المسلم تماماً، بينما ينص المذهب الحنفي جواز تولي المرأة القضاء في الأموال من دون القصاص والحدود).
تحت هذا الخطاب، يُعاد تشكيل العنف ضد النساء كتفوّق ذكوري وكفعل «أخلاقي»، ويُمنَح مشروعية دينية واجتماعية وسياسية. فعندما تُمنَع النساء من الحضور في مراكز اتخاذ القرارات العامة، أو يُفصلْنَ عن الرجال في الأماكن العامة والمواصلات والعمل والتعليم، أو تُفرَض عليهن أنماط لباس معينة، لا يُعرَض ذلك بوصفه قمعاً، بل على العكس، يُقدَّم بوصفه حرصاً على كرامتهن، وحمايةً لهن من «الفتنة»، وحفاظاً على «هيبة المجتمع والدولة»، وبذلك يُعاد تكريس هيمنة الذكور على كل مفاصل الحياة: من حق اتخاذ القرار إلى مناهج التعليم إلى الخطاب الديني والثقافي، ما يجعل من الذكورة شرطاً للفاعلية، ومن الأنوثة موقعاً دائماً للمراقبة والنفي.
السلطة الأبوية وهندسة الذكورة
خلف هذه السلطة الذكورية الجديدة، تقف ذكورة موالية مُعنَّفة ومهزومة ومُهمَّشة بدورها، نشأت من رماد سلطات سابقة مارست قَمعاً ساحقاً على الرجال والنساء معاً، وأعادت إنتاج مفاهيم رجولة مشوّهة، تابعة من الأعلى ومُهيمنة على من هم أدنى. رجال عاديون، ليسوا قادة ولا نخباً، وآخرون من النخب الثقافية والسياسية وقادة مجتمع، يقبلون تماماً بكل ما تقوله السلطة الحالية، فيصبح «عدو السلطة عدوي وصديقها صديقي»، ويدافعون عنها بشراسة، إذ باتوا يتماهَون مع السلطة الجديدة التي وجدوا فيها «نصراً» رمزياً، ولو كان محمولاً على القمع والتعذيب والمجازر واستباحة الآخر «المهزوم» المختلف أو المعارض.
هذا الشكل من الذكورة لم ينبثق من فراغ، إنه نتاج عقود من العنف السلطوي السياسي الذي مارسه نظام الأسد، كما مارسته التنظيمات التي قاتلته، حيث لم يُسحَق الحراك السياسي فقط، بل سُحقت معه الإرادة نفسها، في المعتقلات، ومن خلال التعذيب والإخفاء والاغتصاب وإهانة الكرامة الإنسانية في تفاصيل الحياة اليومية الخاضعة لرقابة الأب والأبن، وتماثيلهما، وهيبتهما المتضخمة التي رسّخت «الأب المُراقِب» كأفق وجودي.
وبعد سقوط الأسد، عملت السلطة الحالية على استغلال هذه الشخصية ذات الإرادة المهزومة وغذّتها بسردية «نصر» متفوقة ومتعالية، لم تتلاشَ السلطة الأبوية، بل أُعيد تشكيلها برموز جديدة. لم تعد هناك صور الأسد وتماثيله، لكن حلّ مكانها رجال ملثمون، سلطة دينية، شيوخ، والأخ المجاهد، لم يتغير جوهر السلطة، بل أدواتها وتَمظهُراتها. الأب القديم اختفى، لكن الأب الجديد المنتصر والحاضر، يحمل سلاحاً وشرعية دينية وحق التشريع باسم الله.
هكذا، يخرج مؤيدون جدد، لم يعرفوا إلا هذا النوع من السلطة، ولا يرون في النساء، ولا في الرجال الذين لا يتوافقون مع «معايير» السلطة المنتصرة، شريكات وشركاء، بل يرون فيهم تهديداً. مؤيدون يقبلون فكرة أن الرجال يحكمون، والنساء يُراقبن. جيل من الموالين يظنُّ أن الهيمنة حق طبيعي، لأنه لم يُدرَّب على المساواة، بل على الانضباط والطاعة وكره الآخر، سواء كان هذا الآخر امرأة، أو كردياً، أو علوياً، أو مسيحياً، أو علمانياً، أو ببساطة: مختلفاً.
ولهذا، يُهاجَم صوت المرأة العالي، كما في قضية الناشطة التي واجهت محافظ السويداء، والناشطة التي تكلمت علناً عن قضية اختطاف النساء، لا لأنه صاخب، بل لأنه يُقاطع الصمت المفروض ويكسر تراتبية السلطة. فجأة، يتحوّل الصوت النسائي إلى قضية «أخلاقية»، «عورة» تُستدعى فيها مفاهيم «الحياء» و«الطهرانية» لتبرير الهجوم، ويُدافع الذكور عن سلطتهم ويحاولون «تطهير صورتها» وإنكار ماضيها تحت غطاء حماية «الهيبة» و«الاحترام»، حتى لو كان الثمن هو التستّر على الانتهاك والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف والعنف الرسمي. يُقدَّم الصوت المرتفع للمرأة كتهديد للمنظومة الأبوية، لا لأنه وقح، بل لأنه صادق ومزعج ومكشوف. ويتوحّد المدافعون عنها، رجالاً ونساءً، لا لحمايتها، بل لإسكاتها وتحييدها، وإعادتها إلى مكانها المُفترَض: هامش الكلام.
لكن العنف لا يتوقّف عند حدّه الرمزي أو الخطابي. بل يتصاعد إلى عنف حقيقي، مادي، ومؤسساتي. لا يُكتفى بإسكات النساء، بل تُطلَق دعوات علنية لمعاقبتهنّ، ومحاكمتهنّ، وحتى ملاحقة المؤسسات أو المنظمات التي يُمثلنها. هكذا، يُطالَب مثلاً بإغلاق المنظمة التي خرجت منها ناشطة تتحدث عن الخطف، بدل التحقيق في الجريمة الأخطر «خطف النساء».
تتحرّك السلطة أحياناً لا فقط بالصمت أو التجاهل، بل عبر أدوات أكثر وضوحاً: طلبات تحقيق بتهم إهانة رموز السلطة أو إهانة الدين، مذكرات توقيف، تهديدات غير رسمية، مطالبات بمحاكمات بذريعة «تهديد الأمن العام». واللافت هنا، أن مؤسسات الدولة لا تتحرك لحماية النساء أو التحقيق في الانتهاكات التي يتعرّضنَ لها، بل تستجيب بسرعة لصوت الغاضبين.
بهذا، تتحوّل المؤسسات من أدوات للعدالة إلى أذرع تنفيذيّة للمنظومة الأبوية، لا تلاحق الجناة، بل تعاقب النساء اللواتي تجرأنَ على الكلام. يصبح الصوت النسوي لا فقط «خطراً أخلاقياً»، بل مادة أمنية، يتم التعامل معها كما لو كانت جريمة في حد ذاتها، لا جزءاً من السعي لكشف الجريمة الأصلية. في هذا السياق، لا يعود القانون وسيلة للإنصاف، بل أداة تُصاغ وفق مقاس السلطة الأبوية، حيث يُمنَح الغضب الذكوري شرعية مؤسساتية، ويُعاد تأديب النساء باسم «الأمن» و«الهيبة» و«النظام العام».
الغياب كنظامٍ سياسي
في سوريا، حيث يُعاد إنتاج الدولة، أو ما تبقّى منها، على أسس طائفية وأبوية ومسلّحة، يصبح تمثيل النساء مجرد كولاج (Collage) تجميلي فوق جدار صلب من الاستبعاد، لا يحمل أي تهديد فعلي للبنية، بل يُسهم في استدامتها عبر تلطيف صورتها. ولا يتوقّف التمثيل الرمزي عند حدود الداخل، بل يُوظَّف أيضاً في خطاب موجه للخارج، كأداة لإقناع المجتمع الدولي بشرعية السلطة الجديدة. بهذا، يُصبح الجندر جزءاً من «دبلوماسية المظهر»، حيث تُستثمَر النساء لا كقوة سياسية مستقلة، بل كأدوات تجميل للهيمنة، وتُختزل العدالة الجندرية إلى سطر في وثيقة دستورية، أو صورة في نشرة، أو رقم في تمثيل. بينما على الأرض، لا شيء يتغيّر: لا قانون يحمي، لا مؤسسات عادلة، ولا خطاب يحرّر، ولا صوت يؤخذ على محمل الجد.
ويظهر ذلك بوضوح في الصور التي تُنتجها السلطة نفسها، من رأس الهرم إلى قاعدته؛ تسود وجوه الذكور، أو بالأصح الذكر المسلم السنّي الموالي، بينما نجد النساء إما مغيّبات كلياً، أو حاضرات في الخلف بوصفهن رموزاً تُستثمر لتجميل المشهد.
تبدأ هذه البنية من صورة اجتماع الفصائل التي قرّرت تعيين الجولاني رئيساً، وجوه رجال، عسكر، جميعهم مسلمون سنّة ومقاتلون، يتقاسمون مراكز القوة والسيادة في مشهد واضح لاحتكار القرار السياسي من قبل فئة واحدة، جندرياً وطائفياً.
ثم تتوالى صور الرجال في القصر الجمهوري، وصور تكريمات «لأبطال» الثورة، ثم صور الفريق التحضيري للمؤتمر الوطني وصور المؤتمر نفسه. وصور الأجهزة الأمنية، ومجلس الأمن القومي، والمحافظين، وكل الدوائر السيادية؛ لا تظهر أي امرأة. تغيب النساء تماماً عن مراكز القرار، التشريع، الإدارة، الأمن، والتخطيط. وكأنهن غير موجودات.
أما صورة الحكومة والوزراء، فتضم 22 رجلاً وامرأة واحدة، بنسبة تمثيل تقل عن 5 بالمئة، وتُقدَّم بوصفها «إنجازاً»؛ تَستثمر السلطة في صورة امرأة واحدة لإسكات ملايين النساء المغيّبات. وهنا، لا يعود السؤال فقط: كم امرأة تمثّلت؟ بل: كيف تمثّلت؟ وفي أي موقع؟ وبأي قدرة على نقد البنية التي تمثّلها؟
لكن السؤال الأكثر إلحاحاً وسط هذا الفيضان من الصور الرسمية المُحكَمة هو: ما الصورة الغائبة؟
أين صورة النساء وهن يصغنَ القرار؟ أين الاجتماع الذي لا تُدعى إليه النساء لمجرد تأدية دور رمزي، بل ليكنّ صوتاً، وفاعلية، وشرعية؟ أين صورة القائدة، والوزيرة، والقاضية، والمفاوضة؟ أين صورة الدولة التي لا تُبنى على احتكار الذكورة وتعزيزها، بل على إعادة توزيع المعنى والموقع والقرار؟ إن الصورة الغائبة ليست مجرد لحظة بصرية مفقودة، بل هي أفق سياسي ممنوع. ولهذا، فإن استعادتها لا تكون بإضافة امرأة هنا أو هناك، بل بتفكيك البنية التي تُنتج هذا الغياب، وتُشرعِنَ حضوره.
أن تكون النساء في الصورة لا يعني أن نَراهُنّ، بل أن نُعيد لهنَّ القدرة على النظر، والقول، والتشكيل، والفعل.
ضد الغياب
في النظام الذي تبنيه سلطة الجولاني، لا يُعاد فقط ترتيب السلطة السياسية واحتكارها، بل يُعاد تصنيع الإنسان نفسه، على قاعدة ذكورية صارمة، متدينة، عنيفة، تُقصي النساء، وتُكافئ الولاء، وتُشيطن الاختلاف. هذا ليس تحوّلاً عابراً في شكل الحكم، بل تأسيس لنظام متكامل يُبنى على هيكلية أبوية تنفي النساء كذات، وكجسد، وكرمز، وكقوة منتجة للمعنى.
ما يُقدَّم اليوم ليس مشروع دولة، بل بنية سلطوية مموّهة، تُمارس عنفها بأدوات متنوعة: مناهج، قوانين، رقابة دينية، رجال أمن ملثمون، ومؤسسات تُدار بروح التنظيم المغلق. النساء لا يُقصينَ فقط، بل يُحوَّلنَ إلى تهديد رمزي دائم، إلى كائنات يجب مراقبتها، تقييدها، وضبط حدود وجودها.
لكن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في رجال السلطة الذين يمارسون هذا العنف، بل في البنية الاجتماعية التي تمنحه الشرعية، وتُعيد إنتاجه بوصفه هوية وطنية، أو دينية، أو ثقافية. في قلب هذه البنية، تستقر المركزية الذكورية كحق طبيعي، يُعاد تعميمه يومياً عبر مؤسسات الدولة والمجتمع والخطاب العام.
في لحظات التحوّل الكبرى، لا تُقاس السلطة فقط بمن يملك القرار، بل بمن يُسمَح له بأن يكون مرئياً، مسموعاً وحاضراً ومُعترَفاً به. وحين تُبنى الدولة من جديد دون النساء، لا يُقصى نصف المجتمع فحسب، بل يُعاد إنتاج الغياب نفسه كنظام سياسي.
ربما لا يكون السؤال الآن عن عدد النساء في الوزارة أو في الصورة، بل عن شكل الزمن الذي يُراد أن نعيشه: هل هو زمن يتّسع لأصوات متعددة، ولتصوّرات مختلفة عن العدالة، والمساواة، والعيش المشترك، والكرامة الإنسانية، والمستقبل؟ أم هو مجرد إعادة نسخ لصورة قديمة، أُفرِغت من معناها، وأُغلق فيها الباب من جديد على النساء؟
موقع الجمهورية
—————————
ما الذي يحدث في وزارة الداخلية السورية؟/ حسام جزماتي
بين خطة العمل المُعلنة وتفاصيل الواقع
22-04-2025
منذ أن وصل أبو محمد الجولاني إلى دمشق فاتحاً، ودفع إلى الواجهة بهويته الحقيقية وباسمه أحمد الشرع؛ أفرج أيضاً عن ذراعيه؛ أسعد الشيباني الذي عُيٍّن وزيراً للخارجية، وأنس خطّاب الذي خلع اسمه الأمني (أبو أحمد حدود) وتولّى رئاسة «جهاز الاستخبارات العامة»، ثم وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية التي يُفترَض أن تعيش لسنوات، بعد وزيرَي تصريف أعمال أداراها بحُكْم الوكيل منذ سقوط نظام بشار الأسد حتى جلس على سُدَّتها الأصيل.
خطّاب، المولود في عام 1987 في مدينة جيرود بريف دمشق، مجرَّب لدى قائده. كان الشابان جنديين في «دولة العراق الإسلامية». وعندما أوفد الجولاني لتأسيس «جبهة النصرة» في سورية التحق به حدود بسرعة. وحين أعلن الأمير انفصاله عن تنظيمه الأم تبعه مُواطنه ومُواليه وأسهمَ في تأمين حمايته والبيوت المتغيرة لإقامته. مما فتح في وجهه باب الترقي في الجهاز الأمني للجماعة، وصولاً إلى رئاسته في سنوات مفصلية وتأسيسية طويلة، بين عامي 2016 و2024.
بالتدريج كانت الثقة بين الرجلين تتوطد، وكانت مهام حدود تزداد دون أن يتخلى الأمن عن مركزه الأول في هذه المهام. وبالنسبة لطموح الجولاني، لم يكن هناك أنسبُ من شخص دؤوب ولا يشكل خطراً، يُفضِّلُ العملَ لوقت طويل في الظل تاركاً للمرتبة الأولى بريقَ الأضواء والتصريحات.
وعلى الرغم من ذلك أقدم خطاب، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تكليفه بالحقيبة كما قال، على نشر مجموعة تغريدات عبر حسابه المستجد على موقع X قبل أيام، يُبيّن فيها خطة عمل وزارته. وكما هي حال السلطة الجديدة في إطلالاتها العلنية ولقاءاتها، حملت الخطة وعوداً عريضة لا أحد يعرف إن كانت ستُنجَز أم لا، تشي بقفزة في هيكلية الوزارة وسياساتها العامة وتقنياتها وبرامجها، وتطوير عصري شامل لمجالات المباحث الجنائية ومكافحة المخدرات والهجرة والجوازات وتحسين السجون والمرور.
لكن ما يستحق الوقوف عنده أكثر هو البند الأول لها، الأقرب إلى التنفيذ زمنياً كما يبدو، والأعمق في الهيكل. وهو إعلان خطّاب عن أن الوزارة ستتمثل «في كل محافظة بمسؤول واحد بدلاً من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولاً عن الشرطة والأمن معاً».
ولفهم الانقلاب الغامض الذي سينشأ عن ذلك، يجدر أن نستعرض مسارَي الأمن والشرطة منذ أن قدما من إدلب مع التحرير، في 8 كانون الأول من السنة الماضية.
جهاز الأمن العام
لم ينضمَّ هذا الجهاز إلى وزارة الداخلية إلا متأخراً، كما لم يكن جزءاً هيكلياً من «هيئة تحرير الشام»، بل بنية مستقلة ترتبط مباشرة بالجولاني وفق الطريقة المُسمّاة «سلطانية». وهذا ليس مَجازاً بل مصطلحٌ كان موجوداً في الحلقة العليا لحكم إدلب. ويعني الأجهزة المتصلة دون وساطة بيروقراطية مع السلطان، مما يمكّنها من تجاوز التعقيدات الرسمية التي قد تتمثل في «حكومة الإنقاذ» التي كانت تدير المنطقة منذ سنوات. بل على العكس، استطاع الجهاز الأمني، عبر آلية «مسؤولي المتابعة» المتوزعين على الوزارات والهيئات، أن يهيمن على الحكومة فضلاً عن سطوته على الحياة العامة.
لكن التظاهرات التي تصاعدت في إدلب خلال العام الفائت، واستهدفت هذا الجهاز بعد انتشار أخبار ما يمارسه من تعذيب في سجونه؛ دفعته إلى التلطي تحت عباءة وزارة الداخلية. فتحول إلى «إدارة» تابعة لها نظرياً دون أن ينقصَ شيءٌ من استقلاله الفعلي، بانتظار هدوء العاصفة وسكون موجة الاحتجاجات.
غير أن ذلك تغير، كما كل شيء في سورية، مع النتيجة المفاجئة لمعركة «ردع العدوان» بسيطرة «الهيئة» على الحكم في دمشق، واضطرارها إلى الحقن المكثف لأجهزتها بالهرمونات لتتضخم وتكفي لإدارة المدن والبلدات والأرياف التي حُصِدَت كغنيمة غير متوقعة ولا يمكن التفريط بها بعد ذلك.
وقد وقعت على جهاز الأمن العام مسؤولية مضاعفة عن سواه. فمن جهة كان عليه أن يحفظ الأمن في بلاد مهددة بالفوضى، ومن جهة كان يجب أن يبدو على قدّ السمعة الطيبة التي حَصَّلها بسرعة صاروخية لدى سوريين لم يكونوا يعرفونه. وفي سبيل ذلك أمضى حدود وفريقه؛ أبو النور الديري وأبو خالد مازوت وأبو بلال قدس وأبو محجن الحسكاوي وأبو عبد الله حوران وأبو الزبير سرايا وسواهم، وقتاً طويلاً وهم يؤسسون الفروع في المحافظات، ويختارون لرئاستها الموثوقين من كوادر الجهاز ومن أبنائها غالباً. وبالنسبة للأعداد، التي كانت لا تتجاوز الألف بكثير وفق التقديرات، جرت زيادتها باستنفار الأصدقاء وأبناء العمومة والمحيط بشكل سريع أولي، ثم بفتح باب التطوع في دورات مكثفة لا تتجاوز الشهر، لرفع أرقام العناصر وتغذية الأرتال المنطلقة في الأرجاء هنا وهناك. وقد شهدت هذه الانتسابات إقبالاً شديداً، في الأوساط العربية السنّية، لما حملته من وعود المكانة والنفوذ، فضلاً عن أنها فرصة عمل معقولة للشبان إذ تنقدهم راتباً شهرياً متوسطاً بالمعايير السورية (120 دولاراً أميركياً). أما رؤساء الفروع فقد مُنحوا، بالإضافة إلى موقعهم الذي يعلو سلطة المحافظ غالباً، رتبة «المقدم» دون خدمة عسكرية سابقة معروفة.
الشرطة
سارت أمور هذا السلك على نحو أهدأ من سابقه إذ لم تقع على عاتقه مهمة تثبيت الحكم ومحاربة الفلول. وقد تقبَّلَ السكان أمر خلوّ المخافر أو ضعفها في بداية التحرير، فقد تبخر الجيش والشرطة معاً عند انهيار نظام الأسد الذي تقول تقديرات مطّلعين إن ملاك وزارة داخليته كان يتألف يومئذ من قرابة ثلاثة آلاف ضابط وحوالي أربعين ألفاً من صف الضباط والعناصر والموظفين المدنيين. ولا يمكن بالتأكيد لطواقم الداخلية القادمة من إدلب تغطية هذا الفراغ إلا بالاستعانة بأعداد كبرى من العاملين السابقين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء. وهي العملية التي تجري الآن بعدما استكملت الفروع بُنيانها بشكل جزئي بالطبع، وصار على رأس كل منها ضابط منشق في معظم الحالات، برتبته الحقيقية أو المُرفَّعة. كما جرى تفعيل إدارات الأمن الجنائي والمباحث الجنائية ومكافحة المخدرات. وأيضاً فتحت الدورات أبوابها في المحافظات وخَرَّجت دفعات متلاحقة من آلاف الأفراد، أي العناصر العاديين.
وبعد؟
لا يتضح بالضبط ما قصده خطاب من توحيد قيادة الجهتين، فلكلٍّ منهما جذوره وعقليته ومهمته وطبيعة مُنتسبيه. بالنظر إلى هذا، وإلى الحقيقة النسبية بأن الأمن العام كان ذراع «الهيئة» المُفضَّل؛ فالمُرجَّح أن يتمدد على حساب الشرطة، بما يعنيه ذلك من ارتفاع الجرعة الأمنية، ولا سيما مع الغياب التام مؤخراً لأخبار جهاز الاستخبارات العامة الذي تولاه خطاب من العدم في البداية. فهو جهاز لم يسبق أن وُجِد، وكانت عملية استيلاده من نخبة الأمن العام مُعطّلة أو بطيئة أو شديدة السرّية، خاصة مع حذر الإعلام الرسمي وقصوره. فمن صور جلسات التهاني بعيد الفطر فقط عرفنا أن عبد القادر طحان (أبو بلال قدس) ترأَّسَ جهاز الأمن العام! ومن آذان الحيطان علمنا أنه تركه إثر خلافات غير متوقعة مع خطّاب حول أمور قيدَ الكتمان!
موقع الجمهورية
——————————–
قرارات المركزي لضبط السوق النقدية تهدد شركات الصرافة شمالي سوريا/ محمد كساح
2025.04.20
تواجه شركات الصرافة لاسيما العاملة في الشمال السوري تحديات وأزمات تهدد الكثير منها بالإفلاس أو الإغلاق، في ظل عقبات تقف أمام جهود المصرف المركزي لإعادة هيكلة وضبط وتنظيم السوق المالية في سوريا، خاصة مع الدور الكبير الذي ما تزال تلعبه شركات الصرافة، سواء المرخصة من قبل النظام المخلوع وحكومتي الإنقاذ والمؤقتة (سابقا)
تواجه شركات الصرافة لاسيما العاملة في الشمال السوري تحديات وأزمات تهدد كثيراً منها بالإفلاس أو الإغلاق، في ظل عقبات تقف أمام جهود المصرف المركزي لإعادة هيكلة وضبط وتنظيم السوق المالية في سوريا، خاصة مع الدور الكبير الذي ما تزال تلعبه شركات الصرافة، سواء المرخصة من قبل النظام المخلوع وحكومتي الإنقاذ والمؤقتة (سابقا) كقناة رئيسية لتدفق الدولار في السوق.
وينص القرار رقم (199/ ل إ) الصادر عن مصرف سوريا المركزي، على تحديد خمسة إجراءات لتسوية المكاتب والشركات أوضاعها، وهي تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يُشعر بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.
وفي المقابل، يمنح القرار مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.
وحدد المصرف مهلة أقصاها شهر تبدأ من تاريخ صدوره في 11 من آذار، لتوفيق شركات ومؤسسات الصرافة المعنية أوضاعها مع أحكام هذا القرار. وأشار القرار إلى أن “عدم الالتزام بتنفيذ الإجراءات يترتب عليه آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة”.
شركات الصرافة والحوالات شمالي سوريا.. تحديات كبيرة
ويرى الباحث ومدير منصة “اقتصادي” يونس الكريم أن شركات الصرافة والحوالات شمال غربي البلاد تشعر بأنها مستهدفة من قبل الحكومة من خلال آلية الترخيص الجديدة التي تمنح امتيازات كبيرة للشركات التي كانت مقربة من النظام المخلوع.
ويلفت خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا إلى أن الآلية الجديدة للترخيص صعبة جدا مقارنة بإجراءات الترخيص البسيطة التي كانت متبعة في المناطق المحررة سابقا، وبقدر ما تعبر الشروط الجديدة عن دخول مرحلة المأسسة إلا أنها قد تفضي في نهاية المطاف إلى إقفال الشركات المالية في الشمال السوري أبوابها نظرا لأن الكلف باتت توازي رأس المال أو تستهلك الجزء الأكبر منه.
ويشير الكريم إلى بعض التحديات الأخرى التي تواجه الشركات المالية ومنها أن قسما كبيرا منها تحول نحو البورصة، عبر المضاربة على العملات الإلكترونية وبالتالي محاولة تحقيق أرباح خلال فترة التجميد ما أدى إلى خسائر فادحة طالت هذه الشركات.
من جانبه يرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن شركات الصرافة في الشمال السوري، تواجه حالياً عدة تحديات، أهمها تراجع نسبي في نشاطها وبالتالي تراجع الدخل ما سبب أزمة مالية للبعض منها، لذلك قد تواجه خطر الإفلاس أو الإغلاق، كما أن نسبة كبيرة منها قد لا تستطيع الالتزام بالمعايير والشروط والضوابط التي حددها البنك المركزي.
ويضيف خلال حديث لموقع تلفزيون سوريا أن نجاح البنك المركزي في ضبط وتنظيم سوق الصرافة في سوريا عموماً وفي الشمال السوري على وجه الخصوص ممكن، لكن يحتاج إلى بعض الوقت، وفي الوقت ذاته هناك تحديات تواجه البنك المركزي في هذا الشأن، أهمها أن بعض مكاتب وشركات الصرافة قد تتجه إلى سوق الظل، بحيث تمارس الصرافة من دون ترخيص، وضبط هذه الظاهرة ليس سهلاً ويحتاج إلى تعاون بين البنك المركزي والجهات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية.
أما فيما يتعلق بقرارات توفيق أوضاع مكاتب الصرافة مع البنك المركزي، فيؤكد أن هذه القرارات تعد التحدي الأكبر الذي يواجه مكاتب الصرافة، كون القرار يشترط على المكاتب الراغبة بالترخيص أن تضع وديعة في المركزي بقيمة مليون وربع المليون دولار وهذا الرقم كبير، وقد لا تستطيع توفيره غالبية الشركات، ما قد يدفعها إما للإغلاق أو للعمل في سوق الظل بشكل غير مرخص، وهذا الأمر قد يعرضها لتبعات قانونية وربما جنائية.
من يتحكم بقرارات المركزي؟
وحول التحديات التي سيواجهها البنك المركزي أمام ضبط سوق الصرافة والحوالات وشحن الأموال خاصة مع الدور الكبير الذي ما تزال تلعبه هذه الشركات كقناة رئيسية لتدفق الدولار، يوضح الكريم أن المصرف المركزي يواجه عراقيل داخلية تتمثل بوجود هيئة تتحكم بسير العمليات المالية والقرارات، لافتا إلى النفوذ القوي داخل البنك لكل من حازم الشرع شقيق الرئيس أحمد الشرع وأبو عبد الرحمن سلامة أحد الأذرع الاقتصادية لهيئة تحرير الشام سابقا، إضافة لبعض الشخصيات ذات التأثير القوي مثل رعد ناصر وعبد الرحمن زربة.
ويرى الكريم أن هذه الشخصيات الأربع باتت هي من يتحكم بالسوق المالية والتحويلات ونقل الأموال، ما يجعل قرارات البنك المركزي غير قابلة للتنفيذ بسبب تعقيدات هذه القرارات ووجود من يتحكم بها من خلف الكواليس.
وبناء على ما سبق، يخلص الكريم إلى أن هذه المؤشرات تجعل من النشاط النقدي لشركات الصرافة والحوالات عملا مرهقا، ومحفوفا بالمخاطر.
ماذا عن الشركات المقربة من النظام السابق؟
يمكن ملاحظة التعاون الكبير مع شركات الصرافة المقربة أو التي كانت محسوبة على النظام السابق، وفي هذا السياق عقد “شام كاش” المقرب من السلطة الجديدة شراكات عديدة مع هذه الشركات، ما يثير إشارات استفهام محقة حول الأسباب التي تلجئ الحكومة إلى هذا التعاون.
وتعليقا، يوضح الكريم أن شركات المالية التي كانت مقربة من النظام المخلوع تملك أصولا واسعة ولديها علاقات دولية متينة ويريد العهد الجديد الاستفادة من هذه الأصول وهذه العلاقات، كما تضطر الحكومة إلى التعامل مع هذه الشركات لمعرفة مصير المبالغ المالية والأرصدة الموزعة على شركات الصرافة والتي لم تتمكن الحكومة من معرفة أماكنها، وذلك لضخ السيولة وعدم حرمان الاقتصاد منها.
وفي المقابل، يشير الكريم إلى الانعكاسات السلبية المترتبة عن استمرار هذا التعاون، ومن أبرزها استمرار العقوبات الغربية نتيجة لبقاء هذه الشركات في العمل، إضافة لمواصلة الفساد وآليات التحكم السابقة التي كانت زمن النظام البائد، وإعادة تشكيل رؤى النظام المخلوع وسياساته بشكل غير مباشر وربما غير مقصود من خلال طبقة التجار التي يتم الاعتماد عليها حتى الآن.
بدوره، يبرر يحي السيد عمر التعاون مع شركات الحوالات المالية كانت تعمل في عهد النظام البائد مثل شركات الهرم والفؤاد، بامتلاك هذه الشركات شبكة واسعة من الفروع، تغطي مساحة واسعة من الجغرافية السورية ما يجعلها شريكا فعالا، على عكس مكاتب الصرافة والحوالات المالية في الشمال السوري، والتي يقتصر نشاطها على مساحة محدودة.
لكنه يتوقع، في الوقت ذاته، أن يضعف اقتصار التعاون على شركات الهرم والفؤاد المنافسة في سوق الصرافة، ويعزز من احتكار هذه الشركات للسوق، مقترحا أن الحل الأفضل هو توسيع مظلة التعاون بحيث يشمل عددا كبيرا من شركات الحوالات المالية، مؤكدا أن هذا الأمر إيجابي بالنسبة للشركات وللعملاء كون الموظفين يصبح بإمكانهم استلام رواتبهم عبر خيارات واسعة من الشركات وعدم إلزامهم بشركات محددة.
ولضبط السوق، يقترح الكريم على البنك المركزي أن يعمل على مستويات عدة داخلية وخارجية، على رأسها ضبط التضخم عبر توفير السماح بتداول الدولار لتوفير السيولة للسوق وخاصة في العمليات الكبيرة لنزع السيطرة من يد شركات الحوالات التي كانت مقربة من النظام السابق، ومراجعة آليات ترخيص الشركات فعوضا عن اشتراط إيداع مبالغ مقطوعة يمكن وضع احتياطي إجباري بالتوازي مع إغلاق الحسابات اليومية في البنك المركزي، كما يقترح إعادة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لتحديد أولويات التمويل، وإعادة تفعيل البنوك بالحياة التجارية و الصناعية لتوليد السيولة .
تلفزيون سوريا
———————–
لبنان وسوريا وفرصة الرعاية السعودية/ رفيق خوري
لا قيمة للإصلاح على الورق من دون سحب السلاح غير الشرعي باعتباره شرطاً لإعادة الإعمار
الأربعاء 23 أبريل 2025
السؤال في سوريا والعالم العربي وأميركا وأوروبا وسط عدم اليقين هو إلى أي حد يستطيع الرئيس أحمد الشرع التخفف من حمولات الجهادية السلفية، ويمكّن الانتقال من انفتاح محدود لـ “هيئة تحرير الشام” إلى انفتاح كامل على التنوع السوري؟
قصيرة كانت فترة العلاقات الأخوية الناعمة بين لبنان وسوريا، من الاستقلال إلى القطيعة الاقتصادية بقرار سوري كان بطله خالد العضم، والباقي غربة ثقافية بين حكام لبنان الكلاسيكيين وضباط الانقلابات العسكرية في سوريا، وصدام سياسي وعسكري عبر أحداث 1958 في لبنان أيام الوحدة المصرية – السورية، ثم استيلاء البعث على السلطة وحكم آل الأسد السلطوي في سوريا والهيمنة عسكرياً وسياسياً على لبنان.
بعد الاستقلال، ومع تأسيس الجامعة العربية، احتاج لبنان إلى رعاية مصرية ودعم سعودي لتثبيت موقعه ودوره وتخلي دمشق عن تحفظاتها عبر جميل مردم بك، واليوم يحتاج لبنان وسوريا إلى رعاية سعودية ودعم أميركي لبناء علاقات طبيعية بين بلدين عربيين، لا في إطار”شعب واحد في دولتين”، كما كان الرئيس حافظ الأسد يردد، ولا في إطار شعبين في دولة واحدة كما كان الواقع الذي فرضته الوصاية السورية، والرياض تعرف من خبرتها ومساعيها المباشرة على مدى أعوام حجم الإرث غير الطبيعي الذي يجب تجاوزه لتنظيم مسار العلاقات الطبيعية بين بيروت ودمشق، فلا بد من أن يتوقف السوريون عن التصرف على أساس أن لبنان “خطأ تاريخي”، وأن يقطع بعض اللبنانيين مع الدعوات التي يعتبر أصحابها أن لبنان “خطأ جغرافي”.
ولا حاجة بعد أكثر من 100 عام للتذكير بأن جبل لبنان كان “متصرفية” ذات حكم ذاتي في ظل السلطنة برعاية الدول السبع الكبرى، وسوريا كانت ولاية عثمانية، وأن الجنرال غورو لم يعلن “لبنان الكبير” عام 1920 قبل أن يدخل دمشق وينفي حكومة الملك فيصل ويرسم حدود الجمهورية السورية تحت الانتداب، بحسب “اتفاق سايكس- بيكو”، وما كان ممكناً الرهان على تجديد الرعاية السعودية والدعم الأميركي قبل التحولات المتسارعة في المنطقة بتأثير حرب غزة ولبنان وسقوط نظام الأسد وانحسار النفوذ الإيراني، وهذا ما سمح بقيام عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة جديدة برئاسة نواف سلام، وإمساك إدارة جديدة بالوضع في سوريا، ومن هنا فرصة البلدين من خلال الرعاية السعودية والدعم الأميركي.
لكن الطريق طويل والتعقيدات ليست قليلة، ففي مراحل التغيير يتذكر المحللون معادلة أنطونيو غرامشي الدقيقة: “القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد، وفي هذه المرحلة يمكن أن تظهر كل أنواع الشرور”، وهي معادلة ليست كاملة بالنسبة إلى لبنان وسوريا، فالقديم في بيروت متجذر والجديد يكافح لئلا يبدو وكأنه ضيف على القديم، والقديم في سوريا مات والجديد ولد، ولكن الجديد يحمل أفكاراً قديمة جداً، والسؤال في سوريا والعالم العربي وأميركا وأوروبا، وسط عدم اليقين، هو إلى أي حد يستطيع الرئيس أحمد الشرع التخفف من حمولات الجهادية السلفية، ويمكّن الانتقال من انفتاح محدود لـ “هيئة تحرير الشام” إلى انفتاح كامل على التنوع السوري؟
من الصعب إلغاء العقوبات الأميركية والاعتراف الرسمي بالوضع السوري الجديد من دون هذا الانفتاح، وهذا ما تدركه تماماً الرعاية السعودية وما تطلبه أميركا والسعودية في لبنان، وفيه هو ما يطلبه اللبنانيون لأنفسهم، الإصلاحات وسحب السلاح غير الشرعي وانسحاب إسرائيل من الأرض التي احتلتها في الجنوب الذي كان محرراً قبل “حرب الإسناد” لغزة بقرار “حزب الله”.
ولا ألغاز وأسرار على الطريق، فجملة واحدة مما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس جوزاف عون تكفي لفهم الترابط بين القضايا المطلوب حلها، “أريد ختم صندوق النقد الدولي”، فختم الصندوق يعني بداية الإصلاح الجدي وتأهيل لبنان للاستثمارات، ولا قيمة للإصلاح على الورق من دون سحب السلاح غير الشرعي الذي هو شرط لإعادة الإعمار، فلا أحد يعيد إعمار بلد مهدد بحروب دائمة، ولا ترسيم للحدود الجنوبية من دون سحب السلاح، أما الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا والتي جرى التفاهم بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري على بدء ترسيمها خلال اجتماع جدة برعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، فإنها جزء من ورشة واسعة.
وليس أكبر من الورشة في لبنان سوى الورشة في سوريا، فكما تحتاج بيروت إلى ختم صندوق النقد الدولي، كذلك الأمر بالنسبة إلى دمشق، ولا ختم للصندوق من دون ختم أميركي، ولا فاعلية للدعم الأميركي من دون الرعاية السعودية التي لا تتوقف مهما يكن المسار طويلاً وصعباً ومعقداً، فالخيار أمام الإدارة الجديدة في سوريا هو، بحسب واشنطن والرياض، بناء دولة الانفتاح والتنوع لضمان وحدة سوريا ورفع العقوبات وبدء إعادة الإعمار وإعادة النازحين مع الدعم الأميركي والسعودي والأوروبي، أو الاستئثار بالسلطة والعيش مع الأزمات والعجز حتى عن إدارة كل سوريا، كما عن منع الفوضى والصراعات المسلحة.
والخيار أمام الجديد وبعض القديم في لبنان هو أخذ ما سميت في إدارة الرئيس دونالد ترمب “الشراكة” مع أميركا والرعاية السعودية عبر الإصلاحات وسحب السلاح، أو اللاشراكة والبقاء في الجحيم الذي قادته إليه المافيا السياسية والمالية والميليشياوية، والمماطلة ليست أقل خطورة وسوءاً من الرفض.
ميشال فوكو استخدم تعبير”السياسة الحيوية” لتوصيف تحكم السلطة بكل مفاصل الحياة، لكن سوريا تواجه خطر السياسة الحيوية ولبنان يعاني ضعف السلطة الذي يوازي أخطار السياسة الحيوية.
——————————–
كيف سيحكم أحمد الشرع سورية؟/ رانيا مصطفى
22 ابريل 2025
هناك اتّفاق بين السوريّين على قبول قوات ردع العدوان سلطةً حاكمةً، وأحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، رغم أن التَّنصيب كان في “مؤتمر النصر” من دون استفتاء شعبي، بل بتوافق فصائل عسكرية، ومن دون مشاركة مدنية أو سياسية. وحتى القوى العسكرية التي لم تحضر قبِلتْ لاحقاً، وهي الفصائل العاملة في السويداء ودرعا، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد توقيع اتفاقٍ بين الشرع ومظلوم عبدي فحواه رغبة الطرفَين في اندماج “قسد” ضمن الدولة السورية الوليدة، أمّا باقي الأطراف المدنية والسياسية، والمجتمعات المحلّية، بما فيها التي كانت تؤيّد نظام الأسد، فهي تتعاطى بواقعية مع الوضع الجديد بسبب الإنهاك من سنوات الصراع، باستثناء مشروع تمرّد ضبّاطٍ من فلول جيش النظام البائد في الساحل السوري (بتحريضٍ من أطراف خارجية) لم يلقَ مشاركةً واسعةً من السوريين العلويين في الساحل.
وعدا عن وجود رغبة لدى عموم السوريين بتجاوز دائرة العنف وآثار الصراع، هناك أسبابٌ أخرى تدفع السوريين لقبول حكم الشرع في المرحلة الانتقالية، وهي أنّه يحظى بقبول دولي وإقليمي باعتباره أقوى الضعفاء المسيطرين على الأرض، والمرشّح لتحقيق بعض الاستقرار. ورغم الشروط الصعبة التي وضعتها واشنطن على حكّام سورية الجدد، ومنها قمع المتطرّفين، وطرد الفصائل الفلسطينية، وإبعاد المقاتلين الأجانب من الأدوار الأساسية، وكشف الأسلحة الكيمياوية وتدميرها، فضلاً عن أمن الأقلّيات الدينية والعرقية وحريتها، إلّا أنّ التوجّه العام يميل إلى إعطائهم الفرصة. قد يزور الوفد الوزاري الاقتصادي السوري واشنطن هذا الأسبوع، وهناك مساعٍ سعودية تدعم تجديدَ رخصة رفع العقوبات الأميركية على سورية، ومنحتَين من البنك الدولي قيمة كلٍّ منهما 150 مليون دولار، كما أن توقيع الاتفاق بين الشرع وعبدي جرى بضغوط أميركية. تستند هذه الخطوات إلى رغبة إدراة ترامب بتخفيض مستوى الصراع في سورية، وسحب قوّاتها تدريجياً، مع منح أنقرة الملّف السوري، وضبط التوتّر التركي الإسرائيلي فيه، وتدعم دول الخليج العربي الاستقرار في سورية، وترغب في الحصول على الاستثمارات، كذلك هو الاتحاد الأوروبي، متحمّس لإعادة جزء من اللاجئين والبحث عن فرص للاستثمار.
هذا التوافق الداخلي والإقليمي والدولي على إدارة سلطة الشرع للمرحلة الانتقالية (ما تزال في أوّلها) لا يعني نجاحَها؛ فهناك عوامل ضعفٍ كثيرة تفيد بأن هذه السلطة ما زالت رخوةً، وأوّلها؛ الصراعات الأيديولوجية داخل قيادات هيئة تحرير الشام، والأخيرة ما زالت تحكم إدلب، ولم تحلّ نفسها كما أُعلن في “مؤتمر النصر”، كما تضمّ فصائل من المقاتلين الأجانب، ويبدو أنّ الشرع يثق بهؤلاء، وقد رفَّع رتب بعضهم في الجيش الجديد، وقلَّدهم مناصبَ قياديةً، وهو يحاول رَتقَ هذا الخرق الكبير في الشروط الأميركية عبر تطعيم الجيش ببعض الضبّاط المنشقّين، كما اتّضح وجود تبايناتٍ أيديولوجية بين الجماعات المنضوية ضمن الهيئة في المجازر الطائفية بحقّ المدنيِّين في الساحل، إضافة إلى تواتر خطابات كراهية ضدّ العلويين في بعض المساجد لدعاةٍ منضوين في الهيئة. وثاني عوامل الضعف مشكلة الفصائل التي بايعت الشرع، وبعضُها يعمل ضمن الأجندة التركية لقتال “قسد”، وحلّها مرتبطٌ بقرار تركي، ويتعلّق بإمكانية دمج “قسد” ضمن الجيش السوري، وطرد المقاتلين الأجانب من صفوفها.
الخروج من الحالة الفصائلية باتجاه جيش احترافي وطني لا طائفي، إذا ما ترافق مع مشروع سياسي وطني تشاركي يمثّل السوريين كلّهم، سيوفّر فرصةً أكبر لحلّ واندماج قوات سوريا الديمقراطية، وفصائل السويداء ودرعا، ضمن الجيش الجديد، ولا تملك الإدارة الجديدة قوّةً عسكريةً منضبطةً قادرةً على السيطرة على الأراضي السورية كلّها، وهذا ما دفعها إلى قبول قوى الأمر الواقع المسيطرة في كلٍّ من شرق الفرات والجنوب السوري، بتوافقات مرحلية تتحكّم بها القوى الإقليمية، مع استمرار التهديد الإسرائيلي، وتوغل جيش الاحتلال في الأراضي السورية، وتصاعد فرص العبث الطائفي الإيرانيّ، وهناك جناحٌ في “قسد” وفي مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) يدعم إداراتٍ ذاتيةً على أسس طائفية.
وثالث عوامل ضعف سلطة الشرع اعتقاده أنّه يمتلك مشروعاً سياسياً واقتصادياً يمكّنه من حكم سورية وحده، عبر استنساخ نموذج إدلب. فسياسياً، حصر الإعلانُ الدستوري السلطاتِ الثلاث في يده، ما يتناقض مع مبدأ فصلها، واستجلب من حكمه في إدلب تجربة “إدارة الشؤون السياسية”، بشخصيّاتها نفسها، إذ ظلَّت موكلةً إلى وزير الخارجية أسعد الشيباني، كما كانت في إدلب، بعد أن صار اسمُها “الأمانة العامّة للشؤون السياسية”، بفروعها في المراكز الإدارية التي يسيطر عليها، وإعادة توظيف أصول حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدّمية، ولجانهما المنحلّة، للسيطرة على مفاصل الحياة السياسية؛ الحزبية والنقابية.
واقتصادياً، لا استقرارَ من دون خططٍ تنموية في ظلّ ارتفاع مستوى الفقر ليصل 90%، وإنّ تعميم نموذج إدلب الاقتصادي على سورية يعني “دولةً نحيلةً”، يقتصر دورُها على الجباية والأمن، وأن تتولّى المنظّمات الدولية تمويل الخدمات الأساسية كالصحّة والتعليم، وهذا لم يعد ممكناً كما كان في إدلب، خاصّة مع التراجع المستمرّ في حجم الدعم الإنساني للسوريين. تجلّى هذا التوجّه في تصريحات حكومة تصريف الأعمال، وبلسانَي الشرع والشيباني، حول نيّتهم تحرير الأسواق، وعرض الموانئ للبيع، وخصخصة القطاع العام، من دون دراسات كافية لجدوى الخصخصة، وبالتالي اتّباع سياسات نيوليبرالية مجحفة بحقّ السوريين، ستقود إلى المزيد من الاضطرابات الاجتماعية. ورغم مرور ثلاثة أسابيع على تعيين الحكومة الانتقالية، ظلَّت سياسة حبس السيولة هي المتّبعة في المصرف المركزي، والتي تنعكس تعطيلاً للإنتاج، ولا يبدو أن الفريق الاقتصادي الجديد يمتلك رؤيةً اقتصاديةً للخروج من الأزمة الحالية، تأخذ بعين الاعتبار تلبية حاجات السكّان الإسعافية، وتسهيل إقلاع عجلة الإنتاج والتصدير، الأمر الذي (لو تمّ) سيشجّع عودة رؤوس الأموال والخبرات السورية، أي مشاركة السوريين في القرار والرهان على القدرات السورية، بدلاً من السعي إلى الحصول على القروض وملء الخزائن من دون خطط تنموية، وفرض شروط التقشّف التي لا يحتملها السوريّون، مع تقديم تنازلات من دمشق، وبعضها سياديّ.
العربي الجديد
————————
الجامع الأموي وهندسة الفضاء الرمزي/ سمر يزبك
22 ابريل 2025
في خطوةٍ مثقلة بالرموز، أعلنت إدارة الجامع الأموي قراراً يقضي بالفصل التام بين النساء والرجال. ورغم أن هذا الإجراء قد يبدو امتداداً لتقاليدَ مألوفةٍ في الثقافة الإسلامية، فإن دلالاته تتجاوز بكثير حدود التنظيم العبادي. نحن أمام لحظة يعاد فيها إنتاج المعنى، لا عبر النصوص فحسب، بل عبر خرائط التجمّع الإنساني وتموضعاته داخل الفضاء العام. إنّه قرار يُعيد توزيع الحضور والغياب، ويكشف أن الفضاء لا يُنظَّم فقط، بل من الممكن أن يُشكَّل مسرحاً للسلطة، فيُعاد إنتاج المعايير والتراتبيات وتوزيعات المشروعية.
لم يعد الجامع الأموي يُقارَب بوصفه مكاناً للعبادة فحسب، بل رمزاً تُعاد هندسته لصياغة ملامح السيادة المقبلة. في هذا السياق، لا يدور الصراع بين الدين والعلمانية، بل بين قوى تتنازع الحقّ في تعريف “ما هو لائق”، وفي ترسيم حدود الجسد والمعنى. قرار الفصل لا يُنظّم الفضاء، بل يُعيد إنتاجه، يُرسّم المركز ويُعيد صياغة الهامش. فالفضاء العام هنا ليس حيّزاً محايداً كما يجب أن يكون، بل هو بنية مُشيّدة مشحونة بالسلطة، تُدار، لا عبر النصوص القانونية أو الدينية (التي تحظى باحترام عموم السوريين) فقط، بل عبر إشارات رمزية، وتوزيعات تبدو “طبيعيةً”، بينما تُخفي وراءها خيارات سياسية وثقافية دقيقة. من هذا المنظور، لا يكون قرار الفصل مجرّد إجراء تنظيمي، بل خطوة ضمن مشروع أشمل لإعادة إنتاج الهرمية الرمزية التي ستشكّل قاعدة النظام المقبل، أيّاً كانت ملامحه أو خطابه المُعلن.
لا يقصي هذا الترسيم الرمزي التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع برجاله ونسائه فقط، بل يُعيد تأطيره ضمن منطق رمزي يضعه خارج مركز الشرعية. ما يُمارَس هنا ليس قمعاً مباشراً، بل شكلاً من “البيو-سلطة”؛ إذ تُدار الحياة عبر هندسة الفضاء، وترميز الأجساد، وتوزيع مواقع الرؤية والسمع والتمثيل. بهذا المعنى، يتحوّل الجامع الأموي مختبراً رمزياً لتجريب أنماط السلطة الجديدة. فالسيادة لم تعد تُعلِن نفسها بالكلمات، بل بطريقة الجلوس، ومسارات الحركة، وتوزيع الرؤية: من يُرى؟ من يُخفى؟ من يُمنح الحقّ في التمثيل، ومن يُعاد إنتاجه صمتاً وظلّاً؟… السلطة، هنا، تُمارَس عبر الجغرافيا لا عبر الخطابة، وعبر اللغة المعمارية أكثر من اللغة السياسية.
وفي لحظة انتقالية كالتي تعيشها سورية، تُملأ الفراغات الرمزية بسرعة. ومن هنا نفهم استعجال الإدارة في فرض الفصل، لا لتقنين الزحام فحسب، بل لترسيخ نمط سيادي ذكوري يتكئ على بنية أخلاقية تبدو تلقائيةً وغير قابلة للنقاش. إن المخيال العام يُعاد تشكيله بطريقة تُنتج عاداتِ نظر، وحدوداً رمزيةً تُرسَم بوضوح؛ الرجل هنا، المرأة هناك. لا حاجة للرقابة، فالخطّ الفاصل نفسه يصبح أداةَ سلطة، ويغدو الحضور فعلاً مقونناً بالصمت والترتيب لا بالمشاركة. غير أن احترام الدين والثقافة الإسلامية لا يعني القبول غير المشروط بكيفيات تجسيدهما داخل الفضاء العام. فالدين، في تموضعه الرمزي العميق، ليس بنيةً جامدةً، بل خطاباً يعيد إنتاج نفسه باستمرار عبر الأزمنة والسياقات. ومن هنا، فإن استدعاء الإسلام في إدارة الفضاء لا يجب أن يتحوّل أداءً شكلياً يُخفي خلفه منطقَ السلطة. إنّ ما يُحترم بحقّ (ويستأهل الدفاع عنه) هو الروح الكونية للرسالة الإسلامية، لا تمظهراتها المحكومة بتقنيات التوزيع السلطوي للأجساد والمعاني. فاحترام المقدّس لا يكون بتجميده داخل هندسات رمزية تُكرّس الهيمنة، بل بتحريره من التوظيف السلطوي الذي يجعله أداةً صامتةً لمأسسة الهيمنة. في زمن تعاد فيه كتابة الخرائط الرمزية للمجتمع، يصبح الدفاع عن الدين هو أيضاً دفاعاً عن حقّه في ألّا يُختزل في بُعدٍ إداري باسم التنظيم.
إن مستقبل سورية لا يُقاس بعدد الوزارات أو بنية الدستور فقط، بل بكيفية تصميم الفضاء الرمزي: الجامع، المدرسة، الشارع، الشاشة. فكل قرار، كالفصل في الجامع الأموي، لا يُنظِّم الأجساد فحسب، بل يُنتِج المعنى، ويُعيد توزيع الشرعية، والظهور، والصمت. وفي التفاصيل الصغيرة، التي تبدو إداريةً، تبدأ الدولة الجديدة بكتابة سرديتها الرمزية، لا بوصفها دولةَ أفراد، بل دولةَ إشارات، تكتب مواطنيها عبر الخرائط، لا عبر النصوص.
العربي الجديد
—————————
المدينة: الكائن الاقتصادي الحي/ مصطفى سيد عيسى
2025.04.22
بعد تخرجي في كلية الهندسة المدنية بسنوات، أجريتُ عددًا من مقابلات العمل للانتقال إلى بيئة عملٍ جديدة. وفي إحدى المرّات قابلت المديرة الإقليمية لشركة استشارية هندسية، وتبادلنا الحديث حول عدد من الجوانب المهنية، وكان من بين ما تحدّثنا به موضوعٌ فتحَ أمامي أفقًا لم أكن قد فكّرت فيه من قبل في مساري المهني. أخبرتها أنني أسكن مؤقّتاً في مدينة قريبة من العاصمة استوكهولم. فأجابت أن المدينة التي ذكرتُها لم تَعد تُعَدُّ مدينةً بالمعنى الحضري الحديث، بل منطقة سكنية بين مدينتين، وأضافت أنّها من أقلّ المناطق جذباً للسكان في السويد.
رأت في عيني اهتماماً واضحاً فاستفاضت في الشرح. قالت إنّها تعمل على تقريرٍ حكومي لجاذبية المدن السويدية للعمل والاستثمار، وكيف أنّ لكل مدينة وظيفة اقتصادية معيّنة تُعزَّز بالتخطيط الحضري والسياسات الحكومية والتسهيلات الإجرائية حتى تبقى لأطول فترة ممكنة محرّكاً للاستثمار والاقتصاد في السويد.
حين نسمع مصطلح “إعادة الإعمار” أو “التخطيط الحضري” وغيره من المصطلحات المتعلّقة بإعادة تأهيل المدن، غالبًا ما تتجه مخيّلتنا إلى مشاهد الإسمنت والجرافات. ولكنّ المساكن وحدها لا تضمن الحياة في المدينة ولا تضمن دورة اقتصادية فعّالة ومستدامة. ولهذا وجب علينا تحديث هذه المفاهيم في أفهامنا وربطها بتصوّر أوسع يساعد على خلق كائن اقتصادي حي في كل مدينة، لا تكون طوبةً صامتة تُبنى اليوم لتعرقل حركة اقتصادية مستقبلية.
في زيارتي لإحدى الدول كُنتُ مهتمّاً بإيجاد سكنٍ مؤقّت فاطّلعت على عدد من البيوت والشقق. كان مظهرها من الخارج لافتاً جداً، وكُنتُ أقرأ عن مساحتها الواسعة وأسقفها المرتفعة، ولكن سُرعان ما دخلتُ البيت لأرى تقسيماته وشعرتُ بضيق غريب وعدم ارتياح لتفاصيله. ممرّات طويلة من دون إضاءة طبيعية، كالدهاليز لا تنقلك على نحوٍ مريح للغرف التي ترغب في الوصول إليها. كان بيتاً كبيراً وواسعاً وجديداً ومبنياً على نحوٍ حديث، ولكنّه كان ضيقاً وخانقاً. هذا بالضبط ما قد يحدث في سوريا إن لم نهتم بهندسية المدينة بشكلٍ يحتضن الحياة ويُنمّي الاقتصاد.
نعيش الآن لحظة مفصلية. فسوريا التي تتأهب لمرحلة إعادة الإعمار، لا تملك ترف الخطأ. وعملية إعادة الإعمار لا يجب أن تكون قراراً للمهندسين أو المقاولين فقط ولكن لخليطٍ شاملٍ من المعماريين والمهندسين والمستثمرين والاقتصاديين وغيرهم من الخبراء.
هناك عددٌ من الأسئلة التي يجب أن تُطرح قبل الانهماك في إعادة البناء. ما هي الرؤية الوطنية لسوريا المستقبل؟ وما هي انعكاسات هذه الرؤية التفصيلية على الأقاليم والمحافظات والمدن؟ ما هي الوظيفة الاقتصادية التي ستُنمّى في المدينة الفلانية؟ وما هي المميزات التنافسية لكل منطقة؟ هذه ليست تساؤلات نظرية، بل مفاتيح لمستقبل سوريا، تتوقف عليها تحولات حقيقية في التنمية والاستقرار.
التموضع الاقتصادي للمدن
عندما نقول إنّنا نريد للمدن السورية أن تكون محرّكاً للاقتصاد وأن تكون كل مدينة كائناً اقتصادياً حياً فيجب علينا التعريف بمفهوم تخطيطي مهم ألا وهو “التموضع الاقتصادي للمدن” والذي يُعرف بالإنجليزية بـ (Urban Economic Positioning) يبحث هذا المصطلح عن وظيفة المدينة وما تُقدّمه للرؤية الوطنية وما يميّزها عن غيرها من المدن.
وتنعكس الإجابة عن هذه التساؤلات في عناصر عديدة كتوزيع الطرق والشوارع، وتموضع المؤسسات والشركات والمناطق السكنية وكذلك تنظيم الأسواق والبنية التحتية والخدمات التي يجب أن تكون في تلك المدينة حتى تستطيع القيام بوظيفتها على نحوٍ صحيح. فكيف لمدينة زراعية أن تغيب فيها الأسواق الزراعية أو المهرجانات الزراعية أو حتى المعاهد والمختبرات العلمية التي تبحث في تطوير المنتجات الزراعية؟ وكيف لمدينة صناعية أن تغيب فيها الشبكات اللوجستية أو الكليات الهندسية الصناعية أو المشاغل التي تصلّح الآلات وتطوّرها؟
خذ مثلًا مدينة حسياء الصناعية قرب حمص. رغم موقعها المتوسط بين حمص ودمشق وتوفر بنية تحتية جزئية، إلّا أنّه لم يُستكمل ربطها بالأسواق والمرافئ والمناطق الصناعية الأخرى فعليا. هذا وقد بقيت معزولة عن مدينة حمص، دون شبكة خدمات حضرية أو لوجستية متكاملة تُشجّع اليد العاملة على العيش فيها أو بالقرب منها. ولهذا كانت النتيجة ضعفاً في الإنتاجية، وتباطؤاً في دوران رأس المال، رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت فيها.
أمّا بالنسبة للجانب الزراعي فيُمكننا أن ننظر لمدينة السلمية في ريف حماة التي تملك من المقومات ما تفتقر إليه مدن سورية أخرى كأرضٍ زراعية خصبة وموقع جغرافي استراتيجي يربط البادية بالساحل وتُراث زراعي عريق يُأهّلها لأن تكون محرّكاً اقتصادياً مهمّا في الجانب الزراعي. ومع كل هذه المقومات، لا تزال المدينة غائبة عن مشهد التنمية. فلم يُركَّز عليها لتكون محرّكاً تنموياً أساسياً يجد المزارع فيها سوقاً أوسع من السوق المحلي لبيع منتجاته ومصانع تحويلية تعينه على تنويع منتجاته الزراعية والمشاركة في التنافس الإقليمي عبر شبكة لوجستية توصل بضائعه لمناطق مختلفة في سوريا وخارجها. وهذا يصبح ممكنًا فقط عندما نضع مدينة السلمية على الخريطة الاقتصادية لسوريا، وندمجها في الرؤية الوطنية للتخطيط الحضري في سوريا.
ولكن وجبت الإشارة إلى أنّ التخطيط الاستراتيجي للمدن (Strategic Urban Planning) لا يهتم فقط بـ أين نبني؟ بل لماذا نبني، ولمن؟ ما الميزة التنافسية التي تملكها المدينة؟ ما نمط المهارات المتوافرة بين سكانها؟ هل فيها جامعات؟ هذه الأسئلة لا تُسأل بعد البناء، بل قبله.
هناك أمثلة كثيرة لمدنٍ ومناطق سورية وجب الوقوف عندها وإعادة النّظر في تخطيطها والاستفادة منها. تُمثّل دير الزور مثلًا، عقدة جغرافية على طريق التجارة مع العراق، يمكن أن تصبح محورًا اقتصاديًا حيويًا إذا ما أُعيد تنظيم حدودها، وتوفير المنافذ التجارية، وبناء بنى تحتية ذكية. أما بعض المدن الساحلية كبانياس وجبلة وما حولها، التي تجتمع فيها الأرض الزراعية والميناء، فيمكن أن تكون نموذجًا لمركز غذائي وتصديري متكامل. كل ذلك يحتاج إلى تخطيط استراتيجي واعٍ.
الفوضى العمرانية، حين تنتج، لا تكون فقط مشهدًا بصريًا مشوهًا، بل عبئًا اقتصاديًا متراكمًا. المدن التي تُبنى دون رؤية اقتصادية تتحول إلى مناطق سكنية هامدة، تستنزف الدولة بالخدمات ولا تقدّم لها شيئاً في المقابل. أما المدن التي تُبنى بناءً على تموضعها ووظيفتها، فتتحول إلى مراكز جذب واستثمار وتنمية.
ما نحتاجه اليوم في سوريا ليس فقط إعادة إعمار، بل إعادة تعريف لمدننا السورية الحبيبة. يجب أن ننظر لكل مدينة وكأنّها مشروع مستقل، له دراسة جدوى وخطة تشغيل ورؤية طويلة المدى. لا يكفي أن نعيد بناء ما تهدّم، بل أن تكون عندنا الجرأة أن نسأل: هل بُنيت أصلًا على أسسٍ صحيحة تخدم سكانها؟ وهل ما نريد بناءَه الآن سيخلق حياة اقتصادية فيها أم سيكون كتلاً خرسانية فقط؟
لا نريد أن نرى المدن السورية بعد سنوات من الإعمار مدناً يُهاجر النّاس منها لانعدام الحياة الاقتصادية فيها بل مدناً يُهاجر النّاس إليها للاستفادة من الحلول الذكية وسلاسة الحياة فيها. لأنّ المدينة في النهاية إمّا أن تكون كائناً اقتصادياً حياً وإما منطقة سكنية ميّتة.
الصمود والاستدامة – ما المقصود بهذا؟
ويقودنا ذلك إلى مفهوم جديد يستحق التعمق والفهم، ويجب أن نأخذه بعين الاعتبار في رحلتنا نحو سوريا المستقبل. كيف نخطط لمدنٍ تُقاوم المتغيرات المستقبلة بأشكالها وأنواعها؟ وكيف تكون الحياة فيها مستدامة ولأطول فترة ممكنة؟ هذا ما سنعرّج عليه في المقال القادم بإذن الله.
تلفزيون سوريا
————————–
قارب النجاة السوري الأخير/ وفاء علوش
2025.04.22
كان اسمه سامر، شاب من حمص، لا يتجاوز العشرين، لم يكن ثائرًا حين بدأت الحكاية، بل كان مجرد شاب يحب كرة القدم ويعزف العود بين أصدقائه، حين انطلقت أولى الهتافات خرج مثل غيره ليرى لا ليشارك، لكنه عاد وهو يرتجف: “صرخوا من أجل الحرية، لكن الجنود ردّوا بالرصاص”.
في الليالي التالية، بدأ سامر يخطّ جملاً صغيرة على قصاصات ورق في غرفته، ويتبادلها مع الأصدقاء لتكون شعارات لافتات المظاهرات في االأيام المقبلة.
ذات مساء، اقتادوه، ظلّت أمه تبحث عنه عامًا كاملًا، باعت ما تملك، دفعت رشاوى، توسلت للضباط، وأخيرًا، عرفت أين يكون ولكن من دون أن تقوى على إخراجه، خرج بعدها بعفو، أو ربما بصفقة لا تعرف تفاصيلها. لم يكن كما كان، انكمش جسده، وصار منكفئاً على وحدته، ولم تستطع محاولات والدته إنقاذه من خيالات ما رآه حيت اعتقل، فقررت أن ترسله خارج البلاد ليبدأ حياة جديدة، سامر الآن لاجئ في بلد بعيد، لقد نجا لكنه لم يُشفَ.
ليست حكاية سامر الوحيدة ربما، فقد مضت سنوات عجاف ارتبطت فيها صورة سوريا بالقتل والتهجير والخيام والمعتقلات، ونعرف جميعاً أنها منذ عام 2015 تصدرت نسبة اللجوء في العالم، وكانت صورة القارب المطاطي هي البطل المطلق في تلك الذاكرة.
وحيداً كان السوري في بؤسه وانعدام حيلته، تخلى عنه العالم إلى درجة اضطر أن يجد لنفسه مخرجاً فشقّ طريقه بأظافره باتجاه ما عدّها نجاة من المحرقة في ذلك الوقت.
لم يكن لدى السوريين فرص كبيرة للنجاة، كان الهروب جزءاً من خطة التمسك بالحياة استجابة لغريزة البقاء، وكان القارب المطاطي هو الشيء الوحيد الذي قد يحقق تلك المعجزة على الرغم مما يحمله من مخاطر وكوارث.
أذكر جيداً حكايات السوريين ممن اضطروا لرمي أوراقهم الثبوتية وحقائبهم في البحر، لتخفيف حمولة القارب الذي كنا نحمّله أكثر من طاقته واستيعابه، تارة من المسافرين وتارة من قدرته على الحفاظ على الحياة، على الرغم من خفته مثل ريشة في مواجهة الرياح.
كانت احتمالات السوريين في العيش وفي البحث عن فرص نجاة محتملة، هشة ضعيفة وغير آمنة لكنها كانت ضرورية ومتفردة وجميلة على الرغم من عيوبها، مثل خط سراب يلوح في أفق الصحراء فنتبعه إلى ما لا نهاية حتى وإن كان الموت عطشاً هو مصيرنا المحتوم.
ركب كثير من السوريين قوارب البحر وذهب كثير منهم قرابين للقضية، وأصبحوا جثثاً تطفوا وتتلقفها الأمواج على غير هدى، كانوا قد يئسوا من النجاة جماعياً فاضطروا للبحث عن خلاص فردي.
لم تكن النجاة مجرد فعل، بل كانت شكلاً من أشكال البطولة اليومية، حين بدأ الموت يتسلل من السماء على شكل براميل، ومن الأرض على هيئة عناصر يقتادون الأرواح إلى غياهب المجهول، لم يكن أمام الناس سوى أن يتحولوا إلى ظلٍ خفيف غير مرئي كي يضمنوا البقاء.
هرب البعض بخطى مرتجفة، يحملون أطفالهم في حضنٍ كاد ينهار من الخوف، يبحثون عن وطنٍ مؤقتٍ خلف الحدود، تسلقوا الجبال، سبحوا في الموت نحو البحر، أو افترشوا الأرصفة في بلاد لا تشبههم، لكنهم تمسكوا بالحياة كما لو أنها آخر قشة في طوفان الوحشية.
بقي آخرون في البلاد ليس من أجل استمرار النضال الذي بات غير ذي نفع أمام آلة الحرب الثقيلة بقدر ما كان السبب هو انعدام الحيلة، لم يكن هناك طريق آخر، اختبؤوا في أقبية تتنفس الغبار، كانوا في الليل يحرسون صمتهم، وفي النهار يربتون على الخوف كأنه طفل جائع.
صرخ السوريون وكتبوا، وتظاهروا، ثم حملوا السلاح حين لم يبقَ من السلم إلا شظايا، قاتلوا لا ليكسبوا، بل ليخسروا بشرف، أنشؤوا مدارس تحت الأرض، وخبزوا الأمل بيدين مرتجفتين، وحاولوا أن يصنعوا وطنًا من الركام.
في وجه المقتلة الأسدية، لم تكن النجاة حياة، بل كانت مقاومة، وكان كل نفس يخرج من صدر سوري هو فعل تمردٍ ضد الموت، ثم جاء التحرير حاملاً معه مساحة أمل أوسع، ولكن حين يسقط الجدار الأخير للطغيان، لا يعني ذلك أن النجاة قد تحققت، فالتحرير ليس لحظة نصر، بل بداية سؤال مؤلم: كيف نحيا من جديد؟
ليست النجاة الجماعية للسوريين حدثًا، بل مسارًا، هي ليست مجرد خروج من سجون النظام، بل خروج من عقد الخوف، من الطائفية، من الثأر، ومن هشيم الروح، فالسوري الخارج من الحرب، ليس فقط بلا بيت، بل بلا ثقة، وبلا يقين، مثقل بالأسى والخذلان.
إن أول شرط للنجاة الجماعية هو أن نصغي لضحايانا، لا أن نطمرهم في النسيان، أن نسمّي القاتل قاتلًا، لا حاكمًا سابقًا، وأن نفتح ملفات الألم لا لنمزقها، بل لنطهرها بالعدالة، فلا نجاة من دون عدالة انتقالية تُنصف المذبوحين، وتكسر سطوة الجلاد، وتُعيد للأمهات بعض الكرامة المسروقة من قبور أبنائهن.
ولا نجاة من دون مصالحة أيضاً، لا أتكلم هنا عن مصالحة سياسية سطحية، بل مصالحة تنبع من القرى، ومن الأحياء، ومن الناس الذين ذبحهم الانقسام أكثر مما ذبحهم الرصاص، مصالحة تبدأ بالاعتراف، لا بالإنكار. بالدموع، لا بالبيانات.
نعم لقد حان وقت الصعود في قارب النجاة جماعة وليس أفراداً، غير أن تلك النجاة ليست مضمونة تماماً، النجاة هنا احتمال علينا أن نعمل معاً من أجله كي لا يصبح حلماً بعيد المنال.
لعلّ المعجزة الحقيقية ليست في سقوط النظام الأسدي، بل في أن السوريين، على الرغم من كل شيء، ما زالوا يؤمنون بأن الحياة تستحق أن تعاش.
إننا في هذه المساحة الممتدة من الشمال إلى الجنوب، لم نعد نبحث عن نصر فقط، بل عن نجاة، ولم نعد نبحث عن خلاص فردي، بل عن شفاء جماعي، عن وطن لا نعيش فيه وحدنا، بل ننجو فيه معًا.
نحن السوريون، أبناء الحلم المكسور، والكرامة التي دُفنت ثم أزهرت، نُريد أن نكسر الحلقة التي تربط الضحية بالجلاد، لا بالدم، بل بالوعي، أن نكسر سيف الحقد، ونرفع مرآة الحقيقة.
نعترف: نحن موجوعون، وغاضبون، ومحبطون، فينا من خسر، وفينا من أذنب، وفينا من ظلّ واقفًا على الحدّ بين الخوف والخطيئة، لكننا نعلن أننا لا نريد أن نتحول إلى نسخ من قاتلينا.
نريد يوماً للصمت لا نُطلق فيه الحكم، بل نسمع، يومًا نصغي فيه لبعضنا من دون صراخ، ونروي فيه للسماء كل ما لم نستطع قوله في الزنازين، وفي المقابر، وفي الغربة، نريد عدالة لا تُبقي القاتل فوق القانون، ولا تبتلع المذنب في ثقب الكراهية، نريد أن نعيد بناء شوارعنا بأيدينا معًا، بكل أخطائنا وتوباتنا.
نريد أن تعود مدارسنا، لا لتلقن، بل لتفتح العيون، أن نُعلّم أولادنا ما جرى، لا ليرثوا الغضب، بل ليفهموا كيف لا يتكرر، لسنا سُذّج، ونعلم أن الغفران ليس سهلاً، وأن من فقدَ أحبته لا يملك قلبًا واسعًا دائمًا، لكننا نعلم أيضًا أن الثأر لا يبني وطنًا، وأن الحقد إن أُطلق، لا يترك أحدًا على قيد الإنسانية.
نريد وطنًا نعيش فيه لا لأننا متشابهون، بل لأننا نحب الاختلاف، ونقدّس الحياة، نريد سوريا التي لا تنجو بشخص، بل بنا جميعًا.
————————
معارك وزير الثقافة المبكرة/ منهل عروب
2025.04.22
أن يُخطئ الوزير، فهذا من طبائع الأمور وربما ضرورات العمل الحتمية. ولكن طريقة التعاطي مع ذلك الخطأ وتحمّل مسؤوليته، فهذا أمر آخر وله دلالات تطول ليس فقط شخصه، ولكن منصبه الاعتباري والجهة التي يُمثّلها، وتطول حتى التيار السياسي أو الفكري الذي ينتمي إليه.
هذا ما حصل مع وزير الثقافة السوري السيد محمد ياسين صالح، الذي قام بزيارة لمدينة البوكمال بدت للوهلة الأولى مجاملة اجتماعية تهدف إلى الاهتمام بالثقافة المحلية لمنطقة الجزيرة التي طالما تجاهلها نظام البعث، أو جولة بروتوكولية يريد أن يتعرّف من خلالها على الشخصيات والتيارات الثقافية هناك، وحلّ ضيفاً على مضافة الشيخ فرحان المرسومي. ولكن الزيارة سرعان ما أثارت جدلاً واسعاً، وفجرت غضب كثير من السوريين الثوريين؛ بسبب ارتباط “المرسومي” السابق بميليشيات إيرانية وتهريب المخدرات، كما يُتّهم بأنه لعب دوراً مركزياً في تجنيد الشباب ضمن “الفوج 47” المدعوم من إيران، وساهم بقوة في تعزيز نفوذ طهران في البنية الاجتماعية والعسكرية للمنطقة قبل سقوط نظام الأسد.مما أدّى إلى موجة من الاستياء الشعبي في المنطقة الشرقية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
أمام تلك الحقائق اضطر الوزير إلى الاعتذار في تغريدة على منصة إكس ـ وهذه سابقة تُحسب للحكومة الجديدة ـ، فثقافة الاعتذار لا تنتمي لمفردات القائد الخالد ولا لفريق عمله بالتبعية. وقد حاول الوزير صالح القطيعة مع تلك الثقافة في خطاب تنصيبه حيث قال نصاً: “إذا أردتُ أن أتحدّث عن الثقافة باختصار شديد، فأقول هي أن نفتّت ونبتعد عن كلّ المنظومة الثقافية التي كان يتبناها الوضيع البائد الهارب الذي كان يحتلّ هذا القصر”. ولكن المشكلة أن هذا الاعتذار لم يكن على مستوى فصاحة كلمات تنصيبه وزيراً، بل جاءت أقرب إلى تبرير بيروقراطي منه إلى اعتراف حقيقي بالخطأ. فلم يوضح السيد الوزير أسباب الزيارة، ولا سبب اختيار هذه المضافة تحديداً ضمن جولته. وحتى في مضمون الاعتذار، فقد حمّل الخطأ للموقف الظرفي، وليس للخلل في التقدير أو نقص في المعلومات لديه أو التحضير السياسي والأمني لفريق عمله.
الزيارة سلّطت الضوء على كثير من جوانب الخلل في عمل الوزارة: منها أنه هل يعقل أن وزيراً لا يعرف طبيعة من يزورهم، وتفاصيل الزيارة ومع من سيلتقي، وما هي المواضيع التي يريد أن يتحدّث بها؟ خصوصاً مع ظهور شقيق الرئيس الشرع ضمن الوفد، مما يدلّ على تداخل واضح في أهداف الزيارة بين الثقافي والسياسي؛ حيث لا رفاهية في فترة تأسيس حكومي ـ لزيارة المجاملات. لا شك أنّ هذا من مهمة فريق العمل في الوزارة، الذي يقوم بتحضير وتجهيز جميع التفاصيل ويُطلع الوزير عليها، ولكن في النهاية الوزير هو من يتحمّل النتائج بصفته الاعتبارية، وموقعه الرسمي.
كما بيّنت الزيارة وسياقاتها غياب أو ضعف “الحساسية الثورية” عند الحكومة الوليدة. فهذا ليس الخطأ الأول لشخصية رسمية في حكومة الشرع، بل سبقه مثلاً لقاء لوزير الصحة السابق (وبغضّ النظر عن كونه شقيق الرئيس، بل نتكلم عن شخصية حكومية) مع الراهبة المؤيدة للأسد والمنكرة لمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية. هذه الأخطاء فتحت الباب واسعاً أمام سؤال العدالة الانتقالية. التشكيك بجدية الحكومة في التعاطي مع قضية العدالة الانتقالية خطير جداً. ولا يبدو أن أعضاء الحكومة تعيره الأهمية المطلوبة؛ ذلك لأن عدم وضوحه يشكك في شرعية الحكومة الوليدة، ويفتح الباب أمام ثقافة الانتقام خارج إطار القانون. كما ينال من رصيد رئيس الجمهورية الذي أغلق هذا الباب، وطلب الثقة بالحكومة الجديدة، وإعطائها الوقت اللازم، وقد نال تلك الثقة. وآخر ما نريد أن نراه هو انهيارها!
ما يجعل هذه الحادثة أكثر إشكالية هو موقع الوزير ذاته. فمحمد ياسين صالح، القادم من خلفية لغوية وأدبية، يُفترض أن يكون ممثلاً لقيم الفكر والنقد والتنوير. واحترام ثقافة الناس ووعيهم. وأن تكون لديه حساسية أكبر تجاه الإجرام ورموزه. هذا الإشكال يعبّر عن قلق أعمق: إذا كانت رموز الدولة الجديدة تزور بهذه السهولة شخصيات متهمة ومحسوبة على النظام المجرم دون
حرص وتدقيق، فماذا عن تطلعات الناس للعدالة، والمحاسبة، والتمثيل الحقيقي؟
فالثقافة ليست زينة سياسية. إنها تمثل الذاكرة الجمعية والضمير العام، الذي يحرص السوريون على الاحتفاظ به. وحين تقف مؤسسات الثقافة ـ ونحسبها بالطبع دون قصد ـ بجانب شخصيات متهمة بالتورط في مشاريع الهيمنة وجرائم الحرب، فهي تفقد حيادها الأخلاقي وتشوّه رسالتها الوطنية.
ما بعد الصورة: أسئلة تنتظر الإجابة
لا يبدو أن السيد الوزير يولي الموضوع الأهمية اللازمة، وهنا تكمن المشكلة. فليست المشكلة في الصورة وحدها، بل في غياب التفسير المقنع، والمحاسبة الواضحة، والموقف المؤسسي. حتى الآن (على الأقل حتى كتابة تلك الكلمات)، لم تُصدر وزارة الثقافة أي بيان توضيحي، ولم تُطرح أسئلة من داخل الحكومة حول مدى مشروعية هذه الزيارة أو مآلاتها الرمزية والسياسية. بل تركت للناشطين الردّ والتبرير، وبالتالي تأجّج الصراع أكثر، وانتقل من قضية واضحة يمكن حلّها بموقف رسمي واضح، إلى مماحكات على وسائل التواصل الاجتماعي بين معارض ومؤيد، وتخوين وتجييش، أوقعت السيد الوزير تحت سياط وسائل التواصل الاجتماعي وشدّها وجذبها، فتحت المجال أمام العديد من الأخبار الزائفة، ستكون المؤسسة الرسمية أول المتضرّرين منها على المدى المتوسط والبعيد. وأولى مفاعيله السلبية، هو المطالبة باستقالة السيد الوزير.
وفي حين أن الاستقالة لا تمثل حلّا في ظروف كهذه، حيث يشكل الأمن والاستقرار أولوية بالغة الأهمية، إلا أنه أيضاً مواجهة هذا الحدث لا يكون بمثل ذلك الاعتذار الباهت، بل بتحمل المسؤولية أمام الناس، وفتح نقاش واسع حول العلاقة بين الثقافة والسلطة، بين الرمزية والتمثيل، والتفريق والتمايز الواضح بين الدولة وعناصر الميليشيات السابقة. لا يمكن للمجتمع السوري أن يبني مستقبلاً ديمقراطياً في حين رموزه الثقافية تتورط ـ بوعي أو غفلة ـ في علاقات ملتبسة مع شخصيات تُمثل النقيض التام لمشروع العدالة والحرية.
الصورة التي التُقطت في مضافة المرسومي لن تُمحى بالاعتذار. لكنها قد تكون فرصة لإعادة تعريف ما تعنيه “الثقافة الرسمية” في سوريا الجديدة. هل هي تكرار لمنهج النظام البائد في تدجين الثقافة لصالح السلطة؟ أم تمثيل صادق لمصالح الناس وآمالهم؟ ما نحتاجه اليوم ليس فقط نقد صورة، بل إعادة بناء الثقة بين المؤسسات الثقافية والجمهور، عبر ، اعتذار مسؤول وليس شكلي، وشفافية ووضوح في التعاطي مع ذلك الخطأ وحيثياته، والجرأة في الاعتراف بالخطأ.. حتى لا تصبح الثقافة مجرد مرآة للنفوذ، بل صوتاً حيّاً للكرامة.
—————————
“سلام” في دمشق: “وعزّ الشرق أوّله دمشقُ”/ عبدالرحمن خوندي
2025.04.22
لم يقل أحمد شوقي أنّ “عزّ الشرق أوّله دمشق” عبثاً، كان يعرف معنى الاستقرار في دمشق فعلاً وتأثيره على الشرق عموماً، وعلى من جاور دمشق خصوصاً.
في لبنان، شارك الشعب اللبناني الشعب السوري معاناته مع النظام الأسدي في عهدي الأب والإبن، إذ كان النظام الأسدي يعتبر لبنان “الأخ الأصغر” الذي يعاني من أمراض عدّة ولا يستطيع السير بنفسه إلا مع تسلط أخيه الأكبر.. هكذا، دخل الأسد لبنان، وعبثت عناصره وأزلامه بالبلد مع كلّ ما عاناه لبنان من حروب وسيطرة ميليشيات طائفية وتدخلات أجنبية.. ولم يعترف الأسد بلبنان كدولة يتمثل بها ديبلوماسياً إلا بعد عام 2008، أي بعدما سيطر حزب الله على زمام الأمر والنهي في البلاد.. وربما يظنّ البعض أن دهشة الصحفيين والسياسيين بحضور العلم اللبناني إلى جانب العلم السوري الجديد مبالغ فيها، لكن هذا أقلّ ما يعيد الاعتبار لهذا البلد الصغير الذي عانى ما عاناه طيلة العقود الماضية.
رسّخت سيطرة نظام الأسد فيما رسخته عبارات عدّة لها أوجه سياسية منها “طالع ع دمشق” و”نازل ع بيروت”، وما بين الطلوع والنزول قرارات وسيطرة ونفوذ، تتلمس هذا الأمر في العلو والانخفاض في العبارتين، فـ”الطالع” يتوجه عند صانع القرار الحقيقي و”النازل” يتلقف القرار ليمليه على من هم “تحت”.. أما اليوم، فلا وجود لهذه العلاقة الفجّة التسلطية ولا لإرثها الثقافي الاستبدادي على الشعبين ولا لما أنتجته من ظواهر، ومن أبرز هذه الظواهر: ظاهرة “حزب الله”.
كلمة السر كانت “رفسنجاني”، فبعد وفاة الخميني وسيطرة حلف رفسنجاني-خامنئي على المشهد الإيراني عام 1989 وانتهاء الحرب مع العراق ونشوء المحور الغربي-العربي المتمثل بأميركا-السعودية-الخليج-مصر، تشكلت انطلاقة جديدة لحزب الله الذي حُصر العمل العسكري في جنوبي لبنان ،والتمثيل الشيعي بشكل عام، به وبحركة أمل، حيث نشأ آنذاك توافق إيراني-سوري بمباركة عربية ومباركة أميركية-أوروبية، إلى جانب انتهاء الحرب في لبنان ووضع اتفاق الطائف الذي وُضع بين المتنازعين برعاية سعودية-سورية والذي ينص في المادة الثالثة منه على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وفي المادة الرابعة على تعزيز العلاقات اللبنانيّة السوريّة.. ومع الاتفاق جاءت القمة الروحية في بكركي عام 1993 التي تشكلت في إثرها اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي في 1995 ومن بعدها تفاهم نيسان بعد عناقيد الغضب في 1996.. كلّ هذا هيّأ لحزب الله نفوذه في لبنان، ولاحقاً نفوذه في الإقليم، حيث نشأ الهلال الشيعي، وخط إيران-العراق-سوريا-لبنان، الذي ترسّخ بعد اشتعال الثورة السورية ضد الحكم الأسدي وتدخل حزب الله والميليشيات الإيرانية لحماية حكم حليفهم الأسد وقمع الثورة السورية.
هذا ما لم يحظَ به من ماثل حزب الله في نشأته وتشكله، مثل حركة التوحيد الإسلاميّة في شمالي البلاد، فأوجه التماثل والشبه بين نشأة حزب الله وحركة التوحيد كثيرة، منها التأثر بمنظمة التحرير الفلسطينية والعلاقة مع إيران (ولو أن علاقة التوحيد مع إيران لم تكن علاقة عقائدية صلبة مثل حزب الله وعلاقته بولاية الفقيه، لكن قيادات التوحيد تأثرت بالثورة الإسلامية في إيران فكرياً إلى حدّ بعيد) والطبيعة المقاومة لإسرائيل، ولكن حركة التوحيد قاتلت النظام الأسدي مع ياسر عرفات آنذاك، كما أن لطبيعتها السنّية ما يعرقل النهج الأسدي المتمثل بتحالف الأقليات والحلم التصديري لثورة إيران الشيعية.
كلّ هذا تلاشى بعد “الحرب الأخيرة” بين حزب الله والعدوّ الإسرائيلي، فما بين حرب تموز 2006 و”جبهة الإسناد” في 2023 أحداث كثيرة أوصلت حزب الله إلى ما وصل إليه اليوم. أولها كان اجتياح بيروت في 7 أيّار 2008 وإعلانه بهذا الاجتياح سيطرته على القرار الداخلي اللبناني بالسلاح، إلاّ إن القيادي عماد مغنية، أحد أعمدة حزب الله العسكرية والأمنية، اغتيل في العام نفسه في فبراير 2008 في دمشق، وهذا ما يمكن أن نعدّه المسمار الأول في نعش حزب الله، وهو ما يقوله العديد من خبراء ومحللي العدو الإسرائيلي في تقديراتهم، وما يؤكد هذا الأمر واقعة البيجر التي حدثت في الحرب الأخيرة والفشل والانكشاف الأمني الرهيب الذي حصل في هذا الحرب باغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله وغالب قيادات الصف الأول.
وهو ما قاله حتى النائب السابق ومسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي في مقابلته الأخيرة على قناة الميادين، حيث قارن بين الإحكام الأمني الذي مثله عماد مغنية في الحزب والفشل الأمني الذي حصل مع الحرب الأخيرة (مع العلم أن الموسوي أحيل للتحقيق بعد هذه التصريحات التي تتناقض مع كلام الأمين العام الحالي نعيم قاسم)؛ أما عن المسمار الثاني، فهو دخول حزب الله إلى سوريا ومساندته نظام بشار الأسد ودفاعه المستميت عنه، فبينما يتوسع نفوذ الحزب خارج لبنان، وبينما يرسم الحزب هذا النفوذ مع إيران، كان العدو الإسرائيلي يتابع تحركاته ويدرسه بدقّة، برعاية روسيّة، وحتى برعاية الأسد الذي تواصل ضباطه مع اسرائيل في الحرب، حسبما كشف تلفزيون سوريا في الحرب الأخيرة وأدلوا بمعلومات عن مواقع وتحركات حزب الله في سوريا، وفي هذا ممكن أن نحشد الكثير من المعلومات والتحليلات التي تؤكد هذا الأمر، فبأقل الاطلاع على ملفات العملاء الذين جندتهم إسرائيل بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان خصوصاً يمكن رصد عدد لا يستهان به من العملاء الذي قاتلوا أو بدأوا قتالهم مع حزب الله في سوريا بعد دخولها إليها، وهذا طبيعي وليس بالصادم لمن التقى بأحد العناصر الذين شاركوا في سوريا، حيث كانوا يتفاخرون بقتالهم ومجازرهم وبما رأوه في سوريا وبتشكيلاتهم العسكرية وقياداتهم، كلّ هذا في أماكن عامة وعلى القهاوي. وبهذا، وبأمور أخرى.. كانت سوريا خصوصاً مقبرة حزب الله.
الآن، تحررت سوريا، وحزب الله مع وداعه الحليف الدموي لا يزال يعيش –هو وإعلامه وأمينه العام- حالة الإنكار، من اشتباكات العشائر البقاعية مع الأمن العام السوري الذي نفى الحزب أي علاقة له بها مع أنه نعى عناصر تابعة له فيها، إلى محاولة الانقلاب التي نفذتها فلول النظام البائد في الساحل والتي يتورط بها حزب الله، إلى خطابات نعيم قاسم التي تؤكد أنه غائب عن المشهد وفي عالم آخر، حتى أنه لمح في خطابه الأول بعد سقوط الأسد إلى أنه من الممكن أن يستعيد خطّ الإمداد.. كيف؟ وبأي طريقة؟ هو نفسه لا يدري، لكن الأجلى هو ما نراه واضحاً في العلاقة السورية اللبنانية الجديدة.. بأنّ نواف سلام في دمشق، والمباحثات في الملفات العالقة جارية، وأنّ عزّ الشرق –قطعاً- أوله دمشقُ.
تلفزيون سوريا
————————————-
لا عودة إلى الوطن.. كيف أعاقت مصادرة نظام الأسد للممتلكات في درعا عودة اللاجئين/ فضل عبدالغني
2025.04.22
في سياقات ما بعد النزاع، يُعترف دوليًا بأن الحق في السكن والأرض والملكية يُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق السلام، وترسيخ العدالة الانتقالية، وضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين والنازحين.
وتُظهر تجارب النزاعات حول العالم أن غياب حقوق ملكية واضحة وقابلة للتنفيذ يُعطل مسارات المصالحة، ويُقوّض جهود التعافي المستدام. إذ تُعد الملكية، في جوهرها، مظلةً للأمن الشخصي والاقتصادي، كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية المجتمعية، والتماسك الاجتماعي، والثقة المدنية في مجتمعات ما بعد الحرب.
في هذا السياق الحرج، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخرًا تقريرًا موسّعًا يُوثّق انتهاكات ممنهجة لحقوق السكن والأرض والملكية، ارتكبها نظام بشار الأسد، تحديدًا في محافظة درعا جنوبي سوريا. وبحسب التقرير، انتهج النظام بشكل مدروس مزيجًا من التلاعب التشريعي، والتدمير المتعمد، والتشريد القسري، والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، كوسيلة لمعاقبة كل من شارك في انتفاضة 2011 أو أبدى تعاطفًا معها.
نُفّذت هذه السياسات تحت غطاء قانوني زائف، عبر مراسيم وتشريعات مثل القانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، والتي لم تكن سوى أدوات لإعادة رسم الخريطة الديمغرافية والاجتماعية لسوريا، ومعاقبة المجتمعات الخارجة عن سيطرة النظام. وقد أدت هذه الانتهاكات المنهجية إلى تمزيق نسيج مجتمعات درعا، مما شكّل عقبة حقيقية أمام أي إمكانية لتحقيق سلام مستدام أو عدالة انتقالية حقيقية. كما أنها باتت تمثّل حاجزًا صلبًا يحول دون عودة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين، ويُبقيهم أسرى المنفى والشتات القسري.
الخلفية والسياق
شكّلت محافظة درعا حجر الأساس في التاريخ الحديث لسوريا، باعتبارها حاضنة للثورة السورية في مارس/آذار 2011، حين تحوّلت إلى ساحة احتجاجات شعبية كبرى مناهضة للنظام. طالبت هذه المظاهرات بإصلاحات ديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، ووضع حد لعقود من الحكم الاستبدادي تحت سلطة نظام الأسد.
في 18 مارس/آذار من العام ذاته، انطلقت أول مظاهرة حاشدة في درعا، وقوبلت بقمع دموي وفوري من قبل أجهزة أمن النظام، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. إلا أن هذا الرد العنيف لم يُخمِد الحراك، بل غذّاه، فامتدت شرارة الاحتجاجات من درعا إلى محافظات أخرى، لتتخذ شكل حركة وطنية واسعة تطالب بالتغيير السياسي الجذري.
جاء رد النظام على هذه الانتفاضة منهجيًا ومدمرًا؛ إذ أطلق العنان لقواته العسكرية، وشنّ حملات اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب واسع النطاق. وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في درعا منذ عام 2011، من بينها ما لا يقل عن 22,443 حالة قتل خارج نطاق القانون، من ضمنها 3,869 طفلًا و2,140 امرأة، بالإضافة إلى 8,706 حالات اعتقال واختفاء قسري شملت 224 طفلًا و194 امرأة. كما تم تسجيل 2,500 حالة وفاة تحت التعذيب، بينهم 19 طفلًا و4 نساء، فضلًا عن 158 هجومًا على منشآت حيوية، شملت 25 مدرسة و35 منشأة طبية.
وفي خضم هذا السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، برزت مصادرة حقوق الملكية كجزء من استراتيجية شاملة اتبعها النظام. وباستخدام أدوات تشريعية تُظهر ظاهرًا من المشروعية، أصدر الأسد سلسلة من القوانين والمراسيم التي شرعنت عمليًا الاستيلاء على ممتلكات المعارضين والنازحين، لتُستخدم هذه الأملاك لاحقًا في إعادة توزيع عقابية تخدم أهداف النظام السياسية والاجتماعية.
الطبيعة المنهجية لانتهاكات الملكية
منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في عام 2011، اتبع نظام الأسد سياسة منهجية لاستهداف ممتلكات المدنيين في مختلف أنحاء سوريا، مع تصاعد ملحوظ لهذه الممارسات في مناطق مثل محافظة درعا. وقد اتسم هذا النهج بالتدمير العمد، والمصادرة الواسعة، والاستيلاء المتكرر على منازل وأراضٍ وممتلكات، تعود بمعظمها إلى معارضين للنظام، أو مختفين قسريًا، أو نازحين، أو لاجئين، بل وحتى أولئك المشتبه في عدم ولائهم.
يعتمد هذا الأسلوب على سلسلة من الخطوات المنظّمة تبدأ عادةً بقصف متعمّد للأحياء السكنية باستخدام أسلحة عشوائية ومحظورة دوليًا، مثل البراميل المتفجرة، والصواريخ الموجّهة، والأسلحة الكيميائية. ونتيجةً لهذا التدمير، يُجبر السكان على النزوح القسري، ليعقب ذلك استيلاء النظام على الممتلكات المهجورة عبر المصادرة أو النهب، ما يُشكّل عقبة مباشرة أمام عودة السكان إلى ديارهم.
في صميم هذه الممارسات، أقر النظام حزمة من القوانين والإجراءات التشريعية التي صُممت خصيصًا لتُضفي مظهرًا قانونيًا على عمليات نزع الملكية الجماعية، تحت ذرائع “إعادة الإعمار” و”التخطيط العمراني”. ومن أبرز هذه الأدوات القانونية:
المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012: رُوّج له كمبادرة لإعادة التطوير الحضري في بعض أحياء دمشق، لكنه استُخدم فعليًا كوسيلة لحرمان المعارضين من ممتلكاتهم، وإعادة تخصيص العقارات ذات القيمة العالية لصالح الموالين والمستثمرين المقربين من النظام.
القانون رقم 23 لسنة 2015: منح الوحدات الإدارية صلاحية مصادرة ما يصل إلى 40% من أراضي القطاع الخاص، تحت مبررات فضفاضة تتعلق بـ”المصلحة العامة”، ما أدى إلى نزع ملكيات من دون تعويض عادل أو سُبل قانونية فعالة للطعن.
القانون رقم 10 لعام 2018: يُعد الأداة التشريعية الأخطر، وقد أثار إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان. فرض هذا القانون إنشاء مناطق تطوير عمراني على مستوى البلاد، مستهدفًا بشكل خاص النازحين، من خلال مهَل زمنية تعجيزية لإثبات الملكية، وهي شروط يستحيل على كثير من الضحايا تلبيتها بسبب النزوح أو السجن، ما سهّل عمليات الاستيلاء الجماعي على ممتلكاتهم.
المرسوم رقم 140 لعام 2023: يمثل أحدث الإضافات في هذا المسار، حيث عزز من قبضة النظام على الملكيات الخاصة تحت ذريعة “إعادة الإعمار”، مما زاد من تعقيد فرص استعادة الممتلكات من قبل المجتمعات النازحة.
التأثير الإنساني: لماذا لا يستطيع اللاجئون العودة؟
لم تقتصر الانتهاكات المنهجية التي ارتكبها نظام الأسد في ملف السكن والأرض والملكية على الدمار المادي فحسب، بل أفضت إلى كارثة إنسانية معقّدة ألقت بظلالها الثقيلة على مستقبل ملايين السوريين. ويمكن رصد ثلاث وسائل رئيسية اتبعها النظام لعرقلة العودة:
التدمير المتعمد ومحو الأحياء:
استُهدفت أحياء وبلدات بأكملها في درعا بالتدمير الممنهج، من أبرزها: طريق السد، اللجين، حي النازحين، خربة غزالة، ونوى. وكما توثق صور الأقمار الصناعية وشهادات السكان، لم يكن الدمار عشوائيًا، بل طال عمدًا البنية التحتية السكنية، والمرافق التجارية، والخدمات الأساسية كالمدارس ومراكز الرعاية الصحية، مما حوّل هذه المناطق إلى بيئات غير صالحة للسكن، اقتصاديًا وماديًا، وجعل من العودة أمرًا شبه مستحيل.
العوائق القانونية والإدارية:
استغل النظام فوضى الحرب لتمرير قوانين تخدم أهدافه في الاستيلاء المنظم على الممتلكات. وبموجب هذه القوانين، مُنحت السلطات غطاءً قانونيًا لمصادرة أراضٍ ومنازل تعود لنازحين لا يملكون إمكانية تقديم وثائق ملكية، بسبب التهجير أو السجن أو اختفاء السجلات الرسمية.
الاحتلال وإعادة توزيع الممتلكات:
في مناطق واسعة، تولّت قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه – سواء محلية أو إيرانية – احتلال الممتلكات المصادرة، أو إعادة توزيعها على موالين وشخصيات نافذة. وقد أُجريت مزادات علنية لهذه الممتلكات، في خطوة تعكس نية واضحة لإعادة تشكيل التركيبة السكانية بطريقة تحول دون عودة السكان الأصليين، وتُعقّد أي محاولة مستقبلية لاستعادة المجتمعات المُهجّرة.
يعاني النازحون من أزمات نفسية متفاقمة، ناجمة عن التهجير المتكرر، وفقدان الأمل، وانعدام الشعور بالأمان بشأن المستقبل.
التأثير على المجتمعات النازحة
لم تتوقف تداعيات انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية عند الأفراد فحسب، بل امتدت لتُخلّف آثارًا إنسانية مدمّرة على بنية المجتمعات النازحة ككل. ويمكن تلخيص أبرز هذه التأثيرات في ثلاث عواقب رئيسية:
• فقدان سبل العيش والاستقرار الاقتصادي
لم تقتصر الانتهاكات على مصادرة المنازل، بل طالت أيضًا الأراضي الزراعية والمنشآت التجارية، التي تُعد مصدر الرزق الأساسي للعديد من العائلات. فقد أدّى الاستيلاء على الأراضي الزراعية في ريف درعا، إلى جانب تدمير البنية التحتية التجارية، إلى تجريد آلاف الأسر من مصادر دخلها واستقلالها الاقتصادي. وفي ظل غياب التعويض أو بدائل اقتصادية حقيقية، وجد اللاجئون والنازحون أنفسهم عالقين في حلقة مفرغة من الفقر والتبعية، غير قادرين على بناء حياة اقتصادية مستقرة سواء داخل سوريا أو في أماكن اللجوء.
• تفكك المجتمع والنسيج الاجتماعي
أدى النزوح القسري إلى تمزيق عميق في النسيج الاجتماعي، فقد تشتّتت العائلات، وتقطّعت الروابط المجتمعية نتيجة للانفصال الجغرافي والاضطرار إلى الهروب من المناطق الأصلية. وأسهمت التغييرات الديمغرافية المفروضة قسرًا، الناتجة عن السيطرة على الممتلكات، في زعزعة البنى الاجتماعية التقليدية، لا سيما في درعا، التي عُرفت تاريخيًا بتماسكها القبلي والمجتمعي. هذا التفكك يزيد من الشعور بالاغتراب والانقسام، ويُضعف من فرص المصالحة الوطنية، ويجعل أي مشروع للعدالة الانتقالية أو التعافي المجتمعي أكثر تعقيدًا.
• استمرار انعدام الأمن والصدمة النفسية
يعاني النازحون من أزمات نفسية متفاقمة، ناجمة عن التهجير المتكرر، وفقدان الأمل، وانعدام الشعور بالأمان بشأن المستقبل. إن عدم القدرة على العودة، أو استعادة الممتلكات، أو إعادة بناء الحياة، يُبقي آلاف العائلات في حالة من القلق الوجودي المزمن، وصدمة ممتدة تهدد الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات على المدى الطويل.
تحليل قانوني
بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تُعد حماية حقوق السكن والأراضي والملكية عنصرًا جوهريًا في تأمين حماية المدنيين في أثناء النزاعات، وتسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار في المراحل اللاحقة للنزاع. وتؤكد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عدم شرعية الاستيلاء التعسفي على الممتلكات الخاصة أو تدميرها، كما تُدين التهجير القسري بوصفه انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.
وفي الحالة السورية، تُشكّل الممارسات التي انتهجها نظام الأسد — من تدمير ممنهج للممتلكات، ومصادرتها، وإعادة توزيعها، ولا سيما في محافظة درعا — خرقًا واضحًا لتلك المبادئ الدولية. ويقدّم توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان دليلًا دقيقًا وشاملًا يُظهر أن هذه الانتهاكات لم تكن مجرد نتائج جانبية للحرب، بل سياسة متعمدة وواسعة النطاق تهدف إلى تفريغ المجتمعات من سكانها، في مخالفة صارخة للمعايير الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
إن استهداف الأحياء السكنية، والأراضي الزراعية، والبنى التحتية المدنية الحيوية وتدميرها لا يمكن تبريره بأي ذريعة عسكرية، بل يُعد إجراءً عقابيًا غير مشروع، يرمي إلى تهجير السكان، ومعاقبة المعارضة، وإعادة تشكيل التركيبة السكانية للبلاد. وتتطابق هذه الأفعال مع التعريف القانوني لجرائم الحرب الوارد في المادة 8(2)(أ)(رابعًا) من نظام روما الأساسي، لكونها “واسعة النطاق”، و”غير قانونية”، و”تُنفّذ بشكل تعسفي”.
إلى جانب ذلك، فإن إصدار النظام السوري سلسلة من القوانين التي أُشير إليها سابقًا يوضح وجود نية ممنهجة لاستخدام التشريع كأداة لتقنين المصادرة والتهجير. وتتناقض هذه القوانين بشكل مباشر مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تُخالف المبادئ الأساسية التي نصّت عليها مبادئ بينهيرو بشأن حماية حقوق الملكية في حالات النزاع والعودة.
علاوة على ذلك، يندرج التهجير القسري الناتج عن مصادرة وتدمير الممتلكات ضمن تعريف الجرائم ضد الإنسانية، كما ورد في المادة 7 من نظام روما الأساسي، خصوصًا عندما يُمارس بشكل ممنهج ضد جماعات يُنظر إليها كخصوم سياسيين للنظام. وتشير البيانات الميدانية بوضوح إلى أن معظم من تعرّضوا للمصادرة أو فقدان ممتلكاتهم، ينتمون إلى مجتمعات تم استهدافها على خلفية معارضتها للنظام، أو بسبب ما اعتُبر “عدم ولائها”.
ردود الفعل والمسؤوليات الدولية
رغم فداحة الانتهاكات التي طالت حقوق السكن والأرض والملكية في سوريا، لا سيما في محافظة درعا، فإن رد الفعل الدولي ظل متواضعًا ومجزّأ، ولم يرتقِ إلى مستوى التحدي الذي تفرضه هذه السياسات الممنهجة. فبالرغم من إدانة العديد من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وحكومات غربية، لسياسات التهجير القسري والمصادرة التعسفية، إلا أن هذه الإدانات لم تُترجم إلى خطوات سياسية أو قانونية فاعلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وقد أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عددًا من القرارات التي تُدين النزوح الجماعي وتدمير الممتلكات، كما سلطت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الضوء مرارًا على التشريعات التي استخدمها النظام لترسيخ سياسات التهجير. إلا أن هذه التصريحات، على أهميتها من حيث التوثيق، بقيت من دون أثر ملموس، في ظل غياب آليات إنفاذ دولية فعالة أو أدوات ضغط حقيقية.
وتبقى جهود التوثيق والسعي إلى تحقيق العدالة الانتقالية رهينة للشلل الجيوسياسي، خاصة في ظل استخدام حلفاء النظام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ما حال دون إحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبهذا، حُرم آلاف الضحايا من حقهم في الانتصاف القضائي، وبقيت الانتهاكات بلا محاسبة.
ملف حقوق الملكية: أولوية ملحّة أمام الحكومة السورية الجديدة
في مرحلة ما بعد سقوط النظام، تواجه الحكومة السورية القادمة تحديًا كبيرًا يتمثل في معالجة ملف حقوق السكن والأرض والملكية، سواء في محافظة درعا أو في سائر المناطق المتضررة. وتُعد هذه القضية مدخلًا أساسيًا لأي مشروع للعدالة الانتقالية وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.
ينبغي أن تبدأ هذه المعالجة بإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي شرعنت الاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وعلى رأسها: القانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، والقانون رقم 23 لعام 2015، والمرسوم رقم 140 لعام 2023، وغيرها من الأدوات القانونية التي شكّلت الإطار التشريعي لسياسات المصادرة والتهجير.
ويجب أن يُستبدل هذا الإطار بمنظومة قانونية جديدة، تكفل استرداد الحقوق أو التعويض عنها من خلال آليات قضائية فعالة تتسم بالشفافية والاستقلالية، وتراعي شمول النازحين داخليًا واللاجئين في الخارج ممن فقدوا ملكياتهم في ظل النظام السابق.
كما ينبغي أن تتضمن خطة الحكومة إنشاء هيئة محلية مستقلة، تتولى مراجعة ملفات المصادرة، والتحقيق فيها، وتحديد المسؤولين عنها، تمهيدًا لإنصاف المتضررين ومحاسبة الجناة. ويمكن لتلك الهيئة التعاون مع منظمات دولية متخصصة، أو الاستفادة من تجارب دول مرّت بمسارات مشابهة، بهدف تطوير آليات ملائمة لتسوية النزاعات العقارية ما بعد الحرب، مع مراعاة التعقيدات القانونية والديمغرافية الخاصة بالسياق السوري.
وأخيرًا، يجب أن تُبدي الحكومة التزامًا وطنيًا يتجاوز الإصلاح القانوني، ليشمل العمل الجاد على ترميم النسيج الاجتماعي المفكك، وضمان التماسك المجتمعي، من خلال مبادرات محلية للعدالة المجتمعية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وتهيئة البيئة السياسية والإدارية اللازمة لعودة آمنة وكريمة للمهجّرين قسرًا إلى مدنهم وبلداتهم.
خاتمة
لم يكن النزاع في سوريا مجرد حرب تقليدية، بل صراع متعدد الأبعاد استهدف الذاكرة والهوية والجغرافيا على حد سواء. وفي درعا، كما في مدن سورية أخرى، تحوّلت أدوات الدولة — من القانون إلى القوة العسكرية — إلى وسيلة للسيطرة والعقاب الجماعي، عبر استخدام السكن والأرض والملكية كوسائل لاقتلاع من حلموا بالتغيير، وإبقائهم في دائرة النفي القسري.
وعليه، فإن هذه الوقائع تمثّل نداءً واضحًا للمجتمع الدولي، ولأي حكومة سورية قادمة، بضرورة الاعتراف بأن حق العودة لا يكتمل من دون استعادة الحق في الملكية. فلا عدالة ممكنة من دون محاسبة حقيقية واسترداد للحقوق. وحتى يتحقق ذلك، ستبقى عودة لاجئي ونازحي محافظة درعا حلمًا مؤجلًا، محفوفًا بالتعقيدات، في حين نأملها عودة كريمة وآمنة كما يستحقون.
تلفزيون سوريا
—————————
العلاقات السورية العراقية.. تحديات قديمة جديدة/ حسن النيفي
2025.04.22
أثار نشرُ الصور التي جمعت كلّاً من الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي وأمير دولة قطر حفيظة العديد من القوى السياسية ذات الارتباط العضوي بإيران.
وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى قطر في الخامس عشر من شهر نيسان الجاري، وقد أوضحت ردود فعل تلك القوى درجة حادّة من الرفض الذي تبديه تلك القوى من أية عملية تقارب بين العراق والقيادة السورية الجديدة وذلك انسجاماً مع موقف تلك القوى المتماهي إلى حدٍّ بعيد مع موقف طهران التي لا تكتفي بالتحفظ حيال الحكومة السورية الجديدة بل تدعو علناً للتحريض على مقاومتها باعتبارها صنيعة مؤامرة أميركية إسرائيلية وفقاً للإعلام الإيراني، إلّا أن السخط الذي وسم موقف تلك القوى العراقية تحوّل إلى تصعيد ممنهج موازاةً مع الدعوة التي وجهها محمد شياع السوداني إلى الرئيس الشرع لحضور الدورة القادمة من لقاء القمة العربية في بغداد في السابع عشر من شهر أيار القادم، وتجسّد هذا التصعيد بمواقف واضحة وصريحة لشطر كبير من أحزاب ( الإطار التنسيقي ) الذي يُعدّ رئيس الوزراء الحالي أحدَ مرشحّيه، كحزب الدعوة برئاسة نوري المالكي الذي أصدر بياناً بهذا الخصوص، وكذلك منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
إرث سياسي متوتر طيلة عشرين سنة
على الرغم من روابط الجغرافيا التي تحكم سوريا والعراق ( 618 كم الحدود المشتركة بين البلدين)، وكذلك على الرغم من حميمية العلاقة بين الشعبين الشقيقين والتي لم تتأثر بتناقض السياسات الحكومية، إلّا أنه لا يمكن الزعم بأن ثمة أساساً سليماً وقويّاً يمكن أن يكون حاملاً لعلاقات وطيدة بين البلدين، فمنذ أواخر سبعينيات القرن الماضي أصيبت العلاقة بين بغداد ودمشق بحالة من ( التسمّم المزمن) نتيجة صراع جناحي حزب البعث الحاكم في كلا البلدين، علماً أن جذور الخلاف لا صلة لها البتة بجوانب فكرية أو إيديولوجية أو تنظيمية، بقدر ما هي سياسية ذات صلة بتوجّه كل سلطة وطموحها التي تسعى إليه وتحاول تعميمه ونمذجته على أنه هو الخيار الذي يمثل التوجه الأمثل للمصلحة القومية. وقد تعزّز هذا التنابذ بوصول الخميني إلى السلطة (1979) وانزياح حافظ الأسد عن مظلة ما يُسمّى آنذاك بـ (جبهة الصمود والتصدّي) وانخراطه في المحور الإيراني، ثم جاءت الحرب الإيرانية العراقية (1980 – 1988) التي شهدت حسماً كاملاً لانحياز نظام دمشق إلى جانب طهران لتؤسس بين الطرفين إرثاً من العداء لا يمكن تجاوزه بسهولة، ولم تكن تداعيات حرب الكويت (1992) بأقل سخونة من الحرب الأولى، من خلال انخراط نظام الأسد في التحالف الدولي المناهض للعراق. وعلى الرغم من الانفراج النسبي للعلاقة المسمومة بين الجانبين بعد موت الأسد الأب وتوريث الابن، إلّا أنها انفراجة شكلية لا تتعدّى مستوًى منخفضاً من العلاقات الدوبلماسية، وكذلك بعض التبادل التجاري ضمن ما يسمح به نظام العقوبات المفروض على العراق آنذاك.
جسّد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 واقعاً إقليمياً جديداً في المنطقة، فما كانت تسعى إيران لتحقيقه في العراق طيلة عقدين من الزمن قد تحقّق لها دفعةً واحدة، إذ بإطاحة واشنطن بنظام العراق باتت إيران هي القابضة على مفاصل الدولة العراقية، إذ باتت المرجعيات الشيعية العراقية، التي تدين بتبعيتها المطلقة للولي الفقيه، هي المصدر الذي تنبثق عنه سياسات الدولة العراقية، بل أصبح العراق برمته مجالاً حيوياً لإيران فضلاً عن كونه أيضاً منطلقاً لامتداد نفوذها نحو دول الجوار العربي، إذ بات من الميسور تعزيز النفوذ الإيراني في لبنان من خلال جسور الجغرافية المتلاحمة من العراق فسوريا فلبنان.
الهيمنة الإقليمية وبسط النفوذ على دول الجوار هي إحدى المعالم الأساسية لسياسات طهران التي لم تتبدّل، واعتمادها على الإيديولوجيا الشيعية واستثمارها للطوائف الشيعية في العالم الإسلامي لا يلغي أبداً البعدَ القومي لمشروعها، إذ يبقى البعد الديني في هذه الحالة أمراً ضرورياً، بل هو الذخيرة اللازمة للتجييش والحشد واستنفار الأنصار، ولعلها عبر هذا المسار استطاعت زج الآلاف من مقاتلي الميليشيات الطائفية في سوريا ليقاتلوا إلى جانب نظام الأسد منذ العام 2012 وحتى تاريخ سقوطه.
الدخول في فلك إيران ليس كالخروج منه
لا ريب أن سقوط نظام الأسد قد جسّد هزيمة لإيران وأذرعها على الجغرافية السورية، إلّا أن حكّام طهران لن يسلّموا بتلك الهزيمة، بل يرون أن الردّ الحقيقي ينبغي أن يكون بدعم (المقاومة الشعبية للمؤامرة الإسرائيلية في سوريا) وفقاً لوكالة (مهر) الإيرانية، كما يتجسّد الردّ أيضاً عبر محاصرة القيادة السورية الجديدة سياسياً واقتصادياً عبر سعيها المستميت لحثّ أذرعها وأدواتها سواء في العراق أو في لبنان لعرقلة وتعطيل أي مسعى للتقارب بين سوريا الجديدة والدول العربية الأخرى، إذ ليس من المستغرب أن ترى طهران في أي تقارب عراقي سوري على أنه ضربٌ من شقّ عصا الطاعة.
بالعودة إلى أسباب رفض بعض القوى العراقية لدعوة الرئيس السوري إلى حضور مؤتمر القمة العربية المقبلة في العراق، يلجأ أتباع إيران إلى النبش في مسائل ذات صلة بوجود الرئيس الانتقالي السوري في العراق إبان الاحتلال الأميركي، وهذه مسألة لا ينكرها الرئيس السوري نفسه، وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قراراً بتبرئة السيد الشرع من أية تبعةٍ جرمية، باعتبار أن قتال المحتل أمر تتيحه جميع الشرائع والقوانين، بل توجبه جميع البواعث الوطنية والدينية، ولكن الأمر الذي لا يأتي على ذكره قادة ميليشيات إيران في العراق هو وجود أكثر من (14000) مقاتل من الميليشيات الطائفية العراقية في سوريا بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان عام 2014، ليس للتصدّي لعدوان خارجي ولا لمواجهة مؤامرة إسرائيلية، بل لقتل السوريين من درعا جنوباً وحتى البوكمال شرقاً، بل إن مشاركة تلك الميليشيات في ذبح السوريين كانت تجري بمقتضى (فتاوى دينية)، ولا يمكن للسوريين نسيان الفتوى الشهيرة لقيس الخزعلي (قائد عصائب أهل الحق) حين عزا أسباب قتل السوريين إلى كونهم من سلالة قتلة الحسين، وجريمة قتل الحسين لا يمكن أن تسقط بالتقادم، بل ستبقى تنتقل من جيل سابق إلى جيل لاحق إلى يوم الدين، بحسب الخزعلي ذاته. وبناء عليه، ثمة جريمة يتحمل وزرها السوريون، وهي قتل الحسين، وهذه الجريمة كانت مطوية تماماً حين كان السوريون يرزحون تحت نير الاحتلال الأسدي، ولكنهم مجرمون – فقط – حين ثاروا على نظام الإبادة وسعوا إلى تحرير بلادهم من سطوة العبودية.
يبقى القول: ثمة مشتركٌ أساسي بين نظام الأسد البائد والميليشيات الطائفية في العراق من جهة ارتباطهما العضوي بإيران، إذ لقد راهن الكثيرون من قبل على فكاك نظام الأسد عن طهران وابتعاده عن تبعيته المطلقة لها واندماجه – بدلاً من ذلك – في محيطه العربي، وكان بالفعل رهاناً فاشلاً، في حين كانت تحيل مجمل الوقائع إلى أن السبيل الأوحد لطرد إيران من سوريا هو زوال الأسد، وهذا ما كان بالفعل. وكذلك الحال بالنسبة إلى القوى الطائفية في العراق، ذلك أن ارتباطها بإيران ليس قائماً على محدّدات سياسية تجسّد مصالح متبادلة بين البلدين، بقدر ما هي قائمة على ولاءات ( عقدية) عابرة لجميع معايير الوطنية، تجعلهم يرون مصالح إيران تتقدّم على أي مصلحة وطنية عراقية. ولعل هذا ما يفسّر إقدام تلك الميليشيات ذاتها على قمع انتفاضة الجنوب العراقي في تشرين الأول عام 2019 حين أقدم العراقيون على إحراق قنصلية إيران في النجف ورفعوا العلم العراقي ومزّقوا صور الساسة والقادة الإيرانيين، وقد أطلقت وكالة (مهر) الإعلامية الإيرانية على المتظاهرين في مقال نشره موقع الوكالة بتاريخ 7 – 10 – 2019 توصيف (سنّة السلطة وشيعة السفارة).
ما لا يمكن تجاهله هو المأزق الصعب الذي يحيط برئيس الحكومة العراقي الذي لا يمكنه تجاهل مطلب أميركي يقضي بالتعاون مع الحكومة السورية لمنع عودة طهران إلى دمشق، وكذلك في الوقت ذاته لا يمكنه تجاوز أصوات شطر كبير من التحالف الذي ينتمي إليه ممّن عيونه على السلطة في العراق، وقلبه معلّقٌ بطهران، فهل ستساهم الضغوط الجديدة للرئيس ترامب على إيران في إيجاد مخرج ولو مؤقت للرئيس شياع السوداني؟.
تلفزيون سوريا
————————
عن لقاء السوداني والشرع في الدوحة/ إياد الدليمي
22 ابريل 2025
منذ اللحظة الأولى لنشر صورة لقاء رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع، برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، سال حبر كثير، وهاجت وماجت وسائل الإعلام العراقية بين مادحٍ تلك الخطوة “الكبيرة” و”الرعاية الكريمة”، ومنتقد (ومتوعّدٍ) السوداني بالويل والثبور وعظائم الأمور، فضاعت بين هذا وذاك تفاصيل كثيرة، ومقاربات أكثر بشأن ما يمكن أن يسفر عنه هذا التقارب، الذي بدا متأخّراً بعض الشيء، ولكنّه على العموم أفضل من ألا يأتي مطلقاً.
بدايةً، لا بدّ من العودة قليلاً إلى الوراء، إلى ما قبل يوم من نشر الصورة التي جمعت السوداني بالشرع في الدوحة (الخميس الماضي)، إذ كانت وسائل الإعلام العراقية، الموالية لإيران وقواها السياسية، تشرع في هجمةٍ واسعةٍ ضدّ السوداني بسبب إعلانه (في ملتقى السليمانية مطلع الأسبوع المنصرم) أن الشرع مُرحّب به في القمة العربية في بغداد (منتصف مايو/ أيار المقبل)، وأنه ستوجّه إليه دعوة رسمية. في خضمّ هذا الهجوم “الولائي” الواسع على السوداني بسبب الدعوة المُرتقَبة، نشرت قناة صابرين (الولائية) في “تليغرام” ما قالت إنها وثائق تُنشر للمرّة الأولى عن الفترة التي قضاها الشرع في العراق، منذ لحظة دخوله واعتقاله من الأميركيين، وحتى لحظة تسليمه للقوات العراقية، ومن ثمّ الإفراج عنه بعد عام 2011، وعودته إلى سورية.
الوثائق التي كان يفترض أنها تدعم الحملة الإعلامية الموجّهة ضدّ السوداني، بسبب دعوته الشرع، أكّدت ما كان قد تحدّث به الشرع (في لقاءات عدّة) عن دوره في أثناء وجوده في العراق، بل زادت على ذلك بأنّها نشرت وثيقةً رسميةً صادرةً من القضاء العراقي تؤكّد براءته من أيّ تهمة، خاصّة أنه اعتقل عام 2005 في الموصل باسم أمجد النعيمي، وبقي تلك الفترة في السجون الأميركية (سجن بوكا)، حتى تسليمه إلى القوات العراقية عام 2010، قبيل انسحاب القوات الأميركية من العراق، وبعد أن قضى عاماً وأكثر في السجون العراقية، وأُفرج عنه لعدم تورّطه بأيّ جناية، وعدم ورود أيّ دعوة بحقّه. نشر الوثائق المتعلّقة بالشرع في أثناء وجوده في العراق برّأه بالكامل من أيّ تهمة تلوكها عادة ألسن معارضي التقارب العراقي مع سورية من الخطّ الموالي لإيران في العراق، بغضّ النظر عن القصد من نشر قناة “ولائية” تابعة لإيران مثل هذه الوثائق في هذا التوقيت تحديداً.
بالعودة إلى الدوحة، تفيد المعلومات بأن طائرة السوداني هبطت في مطار حمد بُعيد الثالثة ظهراً، وغادرت في التاسعة من مساء ذلك اليوم، وأن اللقاء عُقِد في قصر لوسيل برعاية أمير دولة قطر، وحضور رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بمعنى أن اللقاء لم يكن عابراً، وأنه خطّط له جيّداً، والنتائج (بحسب ما نُشِر في بغداد ودمشق) كانت مثمرةً وبنّاءةً، وأفضى الاجتماع إلى تفاهماتٍ تُعزّز العلاقة بين البلدَين.
بقي العراق، منذ سقوط نظام المخلوع بشّار الأسد، يتعامل بتوجّس كبير مع ما آلت إليه الأوضاع في سورية، فقد فقدت إيران، ومن ورائها أتباعُها في العراق، حليفاً استراتيجياً، ونفوذاً كبيراً، ومساحةً واسعةً للتحرّك والمشاغلة في مختلف الجبهات التي تسعى فيها طهران، حتى إن المعلومات كانت تشير إلى غرفة عمليات إيرانية شُكّلت في العراق من أجل إطاحة النظام الجديد، وهو ما تمخضّ في سلسلة أحداث الساحل السوري، ودور تلك الغرفة فيها. وجد العراق الرسمي نفسه محشوراً في زاوية ضيّقة، فهو بين أن يقبل بإقامة علاقة كاملة ومتكاملة مع النظام الجديد، ويستغلّ الفرصة لذلك، وأن يستجيب للضغوط الإيرانية، عبر قواها السياسية والفصائلية في الداخل، إلا أن الأمر تغيّر على ما يبدو، وتحديداً بعد فشل المحاولة الانقلابية في الساحل السوري، إذ أدرك الجميع حينها أنه لا بدّ من التعامل مع الواقع السوري الجديد بواقعية أكبر، خاصّة أن النظام الجديد في دمشق بدا متصالحاً مع نفسه، وواقعياً جدّاً في التعاطي حتى مع خصوم الأمس، والأكثر من ذلك، أنه بدأ يخطو خطواتٍ وازنة في استعادة دور سورية في المنطقة، وهنا كانت اللحظة الفاصلة عراقياً.
عدة اجتماعات قادها السوداني مع قادة الإطار التنسيقي، أفضت إلى أهمّية مراجعة العلاقة مع سورية، فكان أن اتخذ ائتلاف إدارة الدولة (يضمّ قوىً شيعيةً وسنّيةً وكرديةً) قراراً بفتح قنوات التواصل مع سورية الجديدة، فزار بعض ساسة العملية السياسية في العراق دمشق، زياراتٍ غير مُعلَنة، مهّدت للقاء الذي جمع السوداني بالشرع برعاية قطرية في الدوحة. يحتاج العراق إلى سورية في هذه المرحلة المفصلية، فالنفوذ الإيراني يتآكل، والاعتماد على طهران بات خياراً غير مقبول عربياً وإقليمياً ودولياً. وبالتالي، للعراق مصلحة في تجاوز تلك المرحلة، والبحث عن مصالحه بعيداً من إملاءات طهران، حقيقة يدركها قادة “الإطار التنسيقي” في العراق. لذلك، فإن كلّ من يعتقد أن زيارة السوداني إلى الدوحة ولقاءه الشرع هما من دون موافقة القوى العراقية الموالية لإيران واهم. فالسوداني، ورغم ضجيج الإعلام الموالي لإيران، لا يمكنه أن يُقدم على خطوة كهذه من دون ضوء أخضر من القوى السياسية الشيعية الموالية لإيران، خاصّة أنها باتت ترى في الرجل فرصتها الأخيرة لخلاصها، والإبقاء عليها، وعلى وجودها المادّي قبل السياسي، في ظلّ عالم متغيّر، وشرق أوسط جديد يُنذر بعواصف صيفية ساخنة.
——————————
القضاء السوري… جهود لتجاوز عقود من الفساد والمظالم/ ضياء الصحناوي
22 ابريل 2025
تحاول السلطة القضائية السورية التخلص من إرث النظام السابق الحافل بالتجاوزات والفساد والقوانين والمحاكم الاستثنائية، لكن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد، كما تحتاج المحاكم إلى تحديث شامل.
في مبنى محكمة دمشق المدنية، والذي يُشبه متاهة من الممرات الضيقة، ينتظر السوري محمد (52 سنة) لساعات دورَه للاستماع إلى قضيته التي تخص نزاعاً على ملكية أرض ورثها عن أبيه. يقول وهو يقلّب أوراقاً بالية: “قبل سقوط نظام الأسد، كنتُ أخشى حتى الاقتراب من المحكمة. اليوم آمل أن أنال حقوقي، لكن البيروقراطية تلتهم الوقت”.
حالة محمد ليست استثناءً في قاعات المحاكم السورية التي بدأت تشهد تحولات جذرية، لكنها تظل رهينة الكثير من تعقيدات المرحلة الانتقالية، كما أنها محاصرة بإرثٍ طويل من الفساد، فقبل سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، كان القضاء السوري أداةً في يد الأجهزة الأمنية.
ووفقاً لتقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2021، كانت المحاكم تُدار بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات، خاصةً محكمة الإرهاب التي أنشئت في عام 2012، والتي حاكمت آلاف المعارضين من دون ضمانات أو إثباتات قانونية. وبعد سقوط النظام، أعلنت الحكومة الانتقالية نيتها إطلاق إصلاحات شاملة تتضمن إلغاء المحاكم الاستثنائية، وتدريب القضاة.
وأشار رئيس عدلية دمشق، علي المغربي، في تصريحات إعلامية، إلى أن النظام السابق أصدر نحو مليون مذكرة بحث، معظمها لأسباب سياسية أو بناءً على تقارير أمنية مُلفقة، بالمخالفة للأصول القانونية، معلناً إغلاق محكمة الإرهاب التي استُخدمت لقمع المعارضين، وبدء تحضير ملفات قضائية ضد رموز الفساد، بما في ذلك جرائم المقابر الجماعية، والفساد المالي، لعرضها أمام القضاء المحلي والدولي، مع دراسة تطبيق آليات “العدالة الثورية” لإنهاء الأحكام السياسية السابقة.
وبيّن المغربي أن المحاكم تعمل حالياً وفق القوانين السابقة، مع تدوير الدعاوى القديمة، بما في ذلك تلك القادمة من مناطق مثل إدلب، تمهيداً لتوحيد الإجراءات القضائية مستقبلاً، وتحويل منصب “المحامي العام” إلى “رئيس نيابة عامة” جزءاً من إصلاحات هيكلية تهدف إلى فصل السلطات، رغم التحديات المتمثلة في البنية التحتية المتهالكة للمحاكم.
تشهد محاكم سورية تحولات جذرية رغم تعقيدات المرحلة الانتقالية
ويقول المحامي باسل سعيد مانع لـ “العربي الجديد”؛ إنه “في ظل تحوُّلات سياسية غير مسبوقة، تُجسّد المحاكم السورية مشهداً مركباً جزءٌ منه يحمل بصيص أمل بإصلاحات متدرجة، وآخر لا يزال يرزح تحت إرث عقود من التسلط الأمني والفساد، بينما العدالة لا تُبنى إلا بسلامة القضاء. المحاكم لم تعد ساحةً لتدخلات الأجهزة الأمنية كما في السابق، لكنها لا تزال تعاني من إشكالات جذرية، فإلغاء محاكم الإرهاب الاستثنائية لم ينهِ معاناة المُتضررين من أحكامها، والتي لا تزال بانتظار مراجعة لجانٍ فنية شكلتها وزارة العدل حديثاً، هناك أيضاً إشكالية القوانين النافذة، والعديد منها أدوات قمع موروثة عن النظام المخلوع. نطالب بعدالة انتقالية تطهّر الجهاز القضائي من العناصر المتورطة بجرائم النظام السابق، ونقابة المحامين تُجهز لعقد مؤتمرها العام قريباً لإقرار مشروعها في هذا الصدد”.
بدوره، يؤكد المحامي هشام عارف قهوجي، أن عودة المحاكم إلى العمل لا تعني اكتمال وظيفتها، ويوضح لـ “العربي الجديد”: “بالنسبة للقضاء المدني، فقد توقفت دعاوى نقل الملكية بسبب تعطُّل السجلات العقارية ومديريات النقل، وبالنسبة للقضاء الجزائي، فقد تم توقيف المحاكم العسكرية كلّياً، أما في محاكم الجنايات فهناك حالة ترقب حذر إزاء إصدار الأحكام، انتظاراً لتوجيهات جديدة”.
ويقول القاضي طارق برنجكجي، رئيس محكمة الاستئناف الجمركية في دمشق، لـ”العربي الجديد”، إن “المشهد القضائي الحالي، وإن بدا ظاهرياً مشابهاً لما كان عليه في عهد النظام السابق، فإنه يشهد تحولات تدريجية نحو استعادة عافيته، وعدالة القضاء هي مؤشر العافية. وزارة العدل أولت تطبيق القانون وتحقيق العدالة أولوية قصوى، ما انعكس إيجاباً على سير المحاكمات ومرونة إدارة الملفات، وبات بإمكان القاضي تحديد مواعيد الجلسات وفقاً لطبيعة كل قضية”.
ويلفت إلى أن “العدالة لا تعني المساواة الآلية، بل مراعاة الظروف، وهناك فرق بين هدم غرفة غير مرخصة في فيلا فاخرة، وهدم غرفة بسيطة تشكل مأوى لعائلة فقيرة، وهذا رهين بضمير القاضي وحريته في تقدير العدالة، وهي حرية لم تكن متاحة سابقاً. القضاء السوري بدأ يستعيد استقلاليته مع غياب تدخلات السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، على عكس الماضي، حين كان تدخل وزراء العدل سافراً”.
ورداً على انتقادات استمرار بعض القضاة الذين ارتبطوا بالنظام السابق، يوضح برنجكجي أن “شواهد القضاة هي أحكامهم، وليس الانطباعات، والقضاة بشر لا ملائكة، وهم يطبقون القانون ولا يشرعونه. هناك تحديات تواجه القضاء، أبرزها ارتفاع الرسوم القضائية التي تشكل تعقيدات إدارية تعيق مسار الإصلاح، وتوقف سجلات الأحوال المدنية، ما يؤثر على أعمال المحاكم الشرعية، رغم استمرارها في تسجيل عقود الزواج والطلاق، وضعف التنسيق بين المؤسسات، والحاجة إلى إصلاحات تشمل تفعيل السجلات العقارية والأحوال المدنية”.
وفي جولة داخل أروقة المحاكم التي تعمل بوتيرة بطيئة، يوضح محام شاب فضل عدم ذكر اسمه لـ”العربي الجديد”: “العمل القضائي بطيء بعض الشيء، وهذا طبيعي في ظل مرحلة ما زالت البلاد فيها تعمل للخروج من أزمة تشريعية، ومن التسلط الأمني للنظام السابق. نحاول تطبيق القانون من دون تدخلات من أية جهات تنفيذية، والحقيقة أن ذلك أصبح غير مستحيل، لكن يجب إعادة تأهيل السلك القضائي، فمن غير المعقول أن يبقى من كان في صف النظام، والذين نفذوا أوامر الأجهزة الأمنية في السلك القضائي. شخصياً لا أقبل ببقاء أي شخص أصدر حكماً بإيعاز من النظام السابق على رأس عمله”.
وتشير إحصاءات لوزارة العدل إلى أن محاكم العاصمة دمشق تُعالج نحو 20 دعوى يومياً، وجلها قضايا فصل نزاع أو جنح بسيطة، فيما كانت في أواخر حكم النظام السابق تعالج نحو ضعف هذا الرقم يومياً، بينما كان متوسط عدد القضايا التي يتم علاجها قبل 2011، يقترب من 100 يومياً، ويرجع هذا التراجع الكبير إلى عوامل عدة، من بينها هروب عدد كبير من الكوادر القضائية التي شاركت النظام السابق فساده، وأيضاً تعطّل آليات العمل بسبب الحرب، بينما يتراكم نحو مليوني قضية معلقة منذ عهد النظام السابق.
داخل قاعة المحكمة الجزائية، تقول المحامية لينا أبو حمدان لـ”العربي الجديد”: “معظم القضايا اليوم بسيطة، مثل السرقات، والعنف الأسري، والنزاعات على أملاك، أما القضايا السياسية وقضايا الفساد الكبرى، فما زالت مؤجّلة بانتظار التشريعات الجديدة. من القضايا المؤجلة محاكمة ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين شاركوا في سفك الدم السوري”.
ويتفق مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته مع كلام المحامية أبو حمدان، ويؤكد لـ”العربي الجديد”، أن “القضايا الكبرى مؤجلة لعدة أسباب أهمها هروب الجناة أو اختفاؤهم عن الأنظار، ويعطي مثالاً على ذلك؛ باللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السابق، ووفيق الناصر ولؤي العلي اللذين شغلا منصب رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية، وثلاثتهم متورطون في جرائم ضد الشعب السوري. رغم صدور مذكرات اعتقال بحقهم، ترفض الدول التي لجأوا إليها تسليمهم، وهذا يعطل مسار العدالة”.
في عام 2018، كشف تسريب لوثائق من محكمة الإرهاب عن توجيهات مباشرة من المخابرات إلى القضاة حول توجيه التهم للمعتقلين السياسيين. أما اليوم، فلم يعد هناك أجهزة أمنية كي تتدخل. يقول أحد المحامين الذين عملوا في سلك القضاء خلال فترة حكم بشار الأسد، لـ”العربي الجديد”: “كانت الرشوة تُدفع للقاضي عبر وسطاء معروفين، وتقدم العمولات لموظفي المحكمة لتسريع إجراءات ملفّات المتنازعين. أحد الأمثلة على ذلك قضية عائلة الحسيني، والتي حصلت على حكم باستعادة عقارٍ مصادَر في عام 2015، لكن لم تُنفذه إدارة السجل العقاري إلا بعد دفع مصاريف غير رسمية بلغت 500 دولار. الأمر أصبح مختلفاً جذرياً، فلم يعد يجرؤ أحد على فعل ذلك، وهذا جيد إن استمر، فالقضاء على الرشوة ضرورة لضبط سير القضاء”.
ومن أبرز الإشكاليات التي تواجه القضاء حالياً التعامل مع قضاة النظام السابقين، خاصةً من كانوا يُلقّبون بـ”الشبيحة” لارتباطهم الوثيق بالأجهزة الأمنية القمعية، وتشير التقارير إلى أن 40% من قضاة النظام فروا إلى دول أجنبية، من بينها روسيا وإيران، بينما بقي نحو 60% في مناصبهم.
ويقول المحامي إياد أبو حمدان لـ”العربي الجديد”: “هناك ملفات عديدة تثبت تورط عشرات القضاة في تزوير أحكام قضائية لصالح النظام، لكن محاسبتهم تتطلب وقتاً، وبعضهم سيُحاكم، والبعض الآخر سيحاول استخدام علاقاته القديمة للضغط على المسؤولين الجدد، أما بالنسبة للمحامين الموالين للنظام السابق، فقد ألغت نقابة المحامين تراخيص 70 محامياً ثبت تورطهم في تزوير مستندات، لكن بعضهم لا يزالون يمارسون المهنة عبر مكاتب وهمية. النقابة نفسها كانت تُدار سابقاً من أعضاء في حزب البعث، بينما تسعى الآن إلى تطهير سجلاتها عبر لجان قضائية”.
وتنتشر في أوساط السوريين شائعات حول منع المحاميات من الترافع عن موكلين ذكور في المحاكم الشرعية، والعكس، للتحقق من ذلك، في حين أكد عدد من المحامين الذين يترافعون في قضايا الأحوال الشخصية أن القانون لا يمنع ذلك، لكن أحياناً تفرض العادات الاجتماعية هذا الواقع، إذ يطلب بعض القضاة من المحاميات عدم الترافع في قضايا الطلاق أمام الرجال، ويتم الطلب بشكل غير معلن.
ونفى مصدر في وزارة العدل بشكل قاطع وجود أي قرار رسمي يقيّد عمل المحامين حسب الجنس، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن “المحاكم الشرعية تعمل وفق القانون، ومن دون تمييز”.
ورغم إعلان خطط إصلاح طموحة، مثل مشروع الدستور الجديد الذي يُناقش فصل السلطات، تواجه الحكومة الانتقالية عراقيل كبيرة، أحدها تعطّل إقرار قانون “المصادرة والاسترداد” الذي يُفترض أن يُنظم استعادة أملاك المُهجرين قسراً.
ومن الناحية العملية، تعاني المحاكم مشكلات بنيوية، مثل عدم توفر أنظمة رقمية لإدارة الملفات، إذ لا تزال المحاكم تعتمد على الأرشفة الورقية.
رغم هذا المشهد المعقد، هناك إرادة دولية لدعم الإصلاحات عبر برامج تدريب للقضاة، مثل مبادرة الاتحاد الأوروبي “دعم القضاء السوري”، بينما تُحذر منظمات حقوقية من أن “الفوضى الحالية تُنتج فساداً جديداً”، ويلخص أحد القضاة الوضع قائلاً: “نحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه، لكن جذور المشكلة أعمق من أن تُحل بين عشية وضحاها. تحتاج العدالة إلى وقت، والشعب السوري تعود على الانتظار”.
العربي الجديد،
————————-
في ضرورة الوقفة النقدية للواقع السوري/ سوسن جميل حسن
23 ابريل 2025
هل تكفي مدة لم تكمل الشهور الخمسة، أو سقوط النظام السياسي الذي كان يحكم سورية بقبضة أمنية مدعومة بفساد يفوق الوصف، وحكم عائلي جثم على صدور السوريين أكثر من نصف قرن، كي نطلق حكماً بأن “الثورة حققت أهدافها”؟
فرّ الطاغية، وترك خلفه ركاماً من المشكلات المعقدة المتداخلة، تبدو كل واحدةٍ أكثر أولوية من غيرها، مشكلات داخلية وخارجية، لا يمكن فصل بعضها عن بعض، منها الأمن الذي ما زال محفوفاً بالأخطار منذ سقوط بشّار الأسد، بعد نحو 14 عاماً من الحرب التي دمّرت المداميك الأولى التي حلم الشعب السوري، ذات عصر أطلق عليه عصر النهضة، أن يبني عليها مستقبله بما يكفل له العيش في العصر، ويواكب المسيرة الحضارية الإنسانية.
لكن هذا المجال، فائق الحساسية، الأمن، في بلدٍ متعدّد الطوائف والإثنيات، شهد تاريخُه محطّات عنفية عديدة على أرضية التعصّب الطائفي أو القومي، آخرها هذه السنوات الأربع عشرة الأخيرة، يحتاج مقاربة موضوعية وعقلانية وهادفة. وهذا ما لم تنجح الإدارة الحالية في تحقيقه بعد، وبالتالي، تتكرّر مخرجاته باستمرار، بأشكال متنوعة، جديدها أخيراً ما حصل من مجازر في الساحل السوري، ومناطق أخرى، بحقّ مدنيين على أساس طائفي. أما ما يشغل الرأي العام اليوم، ويثير سجالاً كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الوسائط المتعدّدة، فهو ظاهرة “اختطاف” فتيات ونساء من المناطق التي يقطنها السوريون العلويون، في مدن سورية عدة، بينها اللاذقية، حمص، طرطوس، وحماة، في غياب معلومات حول مصيرهن.
“شنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء الماضي، حملة اعتقالات في مدينة حماة، بعد الاشتباه بتنفيذ (عصابة) عمليات خطف وتعذيب، وأعلنت الوزارة اعتقال عدد من الأشخاص”، كما جاء في صحيفة “العربي الجديد” في 18 إبريل/ نيسان الجاري. وهنا سؤال جوهري: لماذا لا تجري الحكومة والجهات المسؤولة عملية تحقيقٍ علنيةٍ تُظهر المرتكبين أمام الشعب؟
أمام هذا السيل الذي يتدفق في وسائل التواصل، وغياب منبر إعلامي رسمي تابع للحكومة، يصل المتابعون إلى أن مجموعات مسلحة غير معنية بالتعليمات أو الأوامر المطالبة بوقف عمليات القتل وخطف النساء واحتجازهن وفق تقليد “السبايا وغنائم الحرب”، كما رأينا في مقاطع مصوّرة، في مقرّات تابعةٍ لها، ولا تتبع لسيطرة الحكومة المؤقتة.
تشير تقارير موثقة صادرة عن منظّمات دولية حقوقية إلى تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري، وسط تفاقم العنف الطائفي، وارتكاب جرائم عديدة كالإعدامات الميدانية، والتهجير القسري، وعمليات القتل الممنهجة، فقد أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها، 3 إبريل/ نيسان، أن مليشيات تابعة للحكومة السورية ارتكبت مجازر بحقّ المدنيين السوريين العلويين في مدينة بانياس والمناطق الساحلية المجاورة، ما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص (ويشير هذا العدد إلى عيناتٍ أخضعتها للتحليل والدراسة)، بينهم أطفال ونساء، في عمليات قتل ممنهجة ذات طابع طائفي. ويحتاج هذا الواقع تحرّكاً سريعاً من الحكومة قبل كل شيء، لحماية الضحايا والنسيج الاجتماعي وقطع الطريق أمام سيول الفوضى المدمّرة. ووفقاً لأحدث تقارير لجنة الرصد والتوثيق التابعة لحركة التجديد الوطني، الصادر في 26 من الشهر الماضي (مارس/ آذار)، فقد استمرّت الانتهاكات الممنهجة ضد الطائفة العلوية بين 7 و26 مارس، متخذة أشكالاً متعدّدة، مثل القتل الميداني، الاختطاف، التعذيب حتى الموت، والتهجير القسري. كما جاء في تقرير لشبكة “يورو نيوز”.
لقد شهد العقد الماضي، أو منذ تحوّلت الثورة في سورية إلى صراع مسلح، انتشاراً سريعاً للعنف والإرهاب والصراع، وكانت المرأة في قلب الحرب والنزاعات التي تجلّت بأشكالٍ لا تعدّ ولا تُحصى من الجرائم والعنف الممنهج. ولكن هل استمرار هذه الممارسات بمبرّرات انتقامية وثأرية، على أساس أن النظام السابق قام بهذه الارتكابات، مبرّر للثورات، ولا يمسّ نزاهتها وقيمها وأهدافها؟ أم من نافل القول الإقرار بحقيقة أنه كانت هناك حالة معيّنة، قبل الحدث الثوري وبعده، تظهر حالة مختلفة تماماً، وهي الانتقال، الذي غالباً ما يكون عنيفاً، من نظام سياسي إلى آخر، بل واجتماعي أيضاً، وبالتالي التعامل بحكمة مع هذا الواقع، ومن منطلق وطني بامتياز؟
في الواقع، ما زالت النساء في قلب الحدث والفوضى السورية منذ 14 عاماً، وكأن هذه السنوات، على الرغم من فداحة ثمنها، لم تُحدث خدشاً صغيراً في الوعي الجمعي، ولم يحدُث أي تغيير، كما يرتجى من الثورات. بل يحزّ في النفس، ويزيد من القلق على مستقبل سورية، التي عاش شعبها، بغالبيته، فرحة الخلاص من كابوس طاغية جثم نصف قرن على صدره، أن شريحة لا يمكن الاستخفاف بحجمها، من النخب الثقافية السورية، تتعامل مع واقعٍ من هذا القبيل بالطريقة نفسها التي يراها عامة الناس، فمنهم من يرى الحديث عن ظاهرة اختطاف الفتيات من الساحل السوري، وغيره من مناطق يقطنها سوريون علويون، محض “شائعات”، ويناشد الحكومة أن تسنّ قوانين صارمة تجرّم من يبث شائعاتٍ من هذا النوع، يرى أنها تثير الكراهية والطائفية والتفرقة، بدلاً من أن يطالب الحكومة بالتحقيق الشفاف والعلني في هذه الظاهرة المدمّرة للعيش المشترك والسلم المجتمعي، وبناء دولة معافاة يمكنها الاستمرار.
هل الثورة تقضي بأن ندير ظهرنا بالضرورة للمستقبل وننظر إلى الماضي، حتى لو كان ما نراه ليس سوى كومةٍ من الدمار والركام والكوارث؟ وهل أكملت الثورة نضالها ووصلت إلى هدفها من أجل الثأرية والانتقام؟ حتى أن شريحة واسعة من السوريين، وبينهم نخب ثقافية، يعلون الصوت أمام كل ارتكابٍ لا يمتّ إلى أخلاقيات الثورة بصلة، ويتعارض مع كل القيم الأخلاقية والحقوقية، فيقولون: هكذا كان النظام يمارس، أو: هل نسيتم ما كان النظام يفعل، أو: أين كنتم؟ مهما بلغ موقف من يندّد بتلك التجاوزات من الوضوح في مناصرته قضايا الشعب السوري.
على الرغم من تكرار “اختطاف النساء” (أو سبيها)، وأنها أصبحت ظاهرة ليست جديدة، في تاريخ بعض الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وشبيهاته، إذ تظهر تقارير ودراسات صادرة عن منظمّات ومؤسّسات أبحاث وإعلام معترف بمهنيتها، أن هناك بعض “السبايا” كن موجودات سابقاً في إدلب ومناطق سورية أخرى، من الأيزيديات، جرى تحريرهن بطريقة أو بأخرى، فإن نكرانها المتكرّر، أو الحطّ من قيمتها وتأثيرها، بمقارنتها بارتكابات النظام الساقط، لا يعد طريقة سليمة في التعامل معها ظاهرة خطرة. وفي حال غياب التوثيق الحكومي والرسمي ظواهر من هذا النوع، لا يمكن الاعتراض على الوصف الخالص والبسيط للوقائع، على أساس أدلّة معينة، يوثقها الأفراد العاديون من ذوي الضحايا بشكل خاص. … تقرير الوقائع، على خلفية أدلة موثوقة، في حد ذاته مصدر حقيقي.
هل تشكّل الثورة اضطراباً كاملاً للنظام الاجتماعي؟ سيكون من التعسّف، في الوقت الحاضر، تعريف الثورة بأنها “تغيير أساسي وسريع، له آثار دائمة، في النظام السياسي والاجتماعي، يؤثّر بشكل أساسي على السكان أنفسهم في مواقفهم وشخصيتهم ونظام معتقداتهم”. كما يقول الأكاديمي الأميركي هارولد ج. بيرمان. وفي المقابل، لا بد من الوقوف عند مقولتين، تعدّ إحداهما إحدى النظريات الثورية تقول إن الثورة مرضٌ له أعراض فسيولوجية ونفسية تؤثر على جسد الدولة وتؤدّي، من خلال تحول عنيف، إلى تحوّل جذري بين نظامين، قديم وجديد. والأخرى: كل ثورة بعينها، وكذلك الظاهرة الثورية ككل، لها مؤرخّوها العظماء. من هذا التأريخ الوطني والعام للثورات، يتشكل “علم الثورات”. أما الثورة السورية، فيلزمها مؤرّخوها العظماء، البعيدون عن الاستقطاب السياسي، علّ “علم الثورات” هذا يفسح لها مجالاً للدرس والتقويم والنقد الذاتي، فالثورة لا تنتهي، وهي في حالة صيرورة مستمرّة، فكل واقع يخلق واقعاً ثوريّاً آخر، بحسب المفكر والفيلسوف جيل دولوز.
—————————-
هل أنجز السوريون الاستقلال حقّاً؟/ مروان قبلان
23 ابريل 2025
احتفل السوريون الأسبوع الماضي (17 إبريل/ نيسان)، بالذكرى 79 لجلاء المستعمر الفرنسي عن بلادهم (1946). بالنسبة لكثيرين منهم، كان الشعور بالاستقلال هذه المرّة مضاعفاً، بعدما انزاح عن صدورهم استعمار آخر لا يقل سوءا، جسّده نظام الأسد بدمويته وإجرامه، واستعانته بالأجنبي على أبناء شعبه، لذلك حُق للسوريين أن يحتفلوا بالاستقلال مرّتين من الآن فصاعدا: يوم 17 إبريل، ويوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول. مع ذلك، ورغم الشعور العارم بالارتياح بين عموم السوريين، من كل الطوائف والإثنيات، بزوال نظام الأسد، وانتهاء حقبة مظلمة في التاريخ السوري المعاصر، يبقى الاستقلال السوري منقوصاً، غير ناجز، تجسّده تحدّيات كبيرة ثلاثة: أولها، وجود أربعة جيوش أجنبية، على الأقل، على الأرض السورية، وما يفرضه ذلك من استمرار انقسام البلاد وعدم قدرة دمشق على بسط سيطرتها على كامل التراب السوري. لن يكون التعامل مع هذا التحدّي سهلاً، إذ تحتفظ قوتان عظميان بوجود عسكري على الأرض السورية (الولايات المتحدة وروسيا)، ولا يبدو واضحاً كيف ستكون العلاقة بينهما، أو بينهما وبين الإدارة الجديدة في دمشق، فسياسة إدارة الرئيس ترامب السورية ما زالت غير واضحة، تتنازعها اعتباراتٌ داخليةٌ وخارجيةٌ متعدّدة، ولا نستطيع، من ثم، تبيّن هدفها النهائي: هل تسعى إلى ضبط التغيير في دمشق، هل تحاول إعادة تشكيل النظام الجديد فيها، هل تنحاز للمقاربة الإسرائيلية الرافضة له بالمطلق؟ ينطبق الشيء نفسه على السياسة الروسية التي يبدو أنها أيضاً في طور المراقبة والانتظار لما تسفر عنه مراجعة واشنطن سياستها السورية، قبل أن تقرّر خطوتها التالية. إقليمياً، يحتدم صراع النفوذ بين تركيا وإسرائيل في الساحة السورية، ما يهدّد بإغراق البلاد في فوضى جديدة، علماً أن إسرائيل احتلت أراضي سورية جديدة بعد سقوط نظام الأسد، وتفرض نوعاً من “الوصاية” على مناطق أخرى في جنوب البلاد، مانعة سلطات دمشق من الوصول إليها. تركيا أيضاً لديها مصالحها في سورية وهي على الأرجح لن تسحب قواتها من شمال البلاد قبل أن تضمن تلك المصالح، وفي مقدمها حل المسألة الكردية، وترسيم الحدود البحرية، وإعادة توطين اللاجئين.
ثاني التحدّيات التي تواجه سورية وتجعل استقلالها منقوصاً يرتبط بالاقتصاد وإعادة الإعمار. لا يقل هذا التحدّي صعوبة عن الأول، فبسبب الحرب والدمار وسياسات النهب التي مارسها النظام البائد، يرزح 90% من السوريين اليوم تحت خط الفقر، ومع الفقر تأتي كل الموبقات التي يمكن أن يتخيّلها المرء، وفي مقدمها الجهل، والجريمة، والتعصب، والإحباط، والميل إلى العنف والاحتجاج. لا يمكن إعادة بناء بلد والنهوض به و90% من مواطنيه لا يجدون قوت يومهم، ولا يمكن ذلك أيضاً وهم معتمدون كلياً على الخارج في تأمين أبسط احتياجاتهم من غذاء، ودواء، وطاقة، وغيرها. هذا يعني أن سورية ستبقى إلى أن تمتلك أدوات القوة، وتحقق القدرة الذاتية على النهوض، دولةً تابعةً خاضعة لشروط المانحين، وهذا أكبر انتقاصٍ من سيادتها واستقلالها.
يرتبط ثالث التحدّيات بالقدرة على وضع برنامج أو خطّة واضحة للانتقال السياسي، تحدّد، من دون لبس، أين تتّجه البلاد، وأين سنصل في نهاية هذه المرحلة. هذا ضروري لبناء الثقة، طمأنة السوريين إلى مستقبل بلدهم، وإشعار جميع مكونات المجتمع بأن لهم مكاناً في سورية المستقبل، فتصبح معول بناء لا معول هدم. هذه الخطوة ضرورية أيضاً للإجابة عن الأسئلة التي تخطر ببال كل سوري اليوم (خاصة رجال الأعمال) هل يعود إلى سورية، هل يستثمر فيها، هل سيكون هناك استقرار؟ هذا مهم، فوق ذلك، لإقناع الفصائل المسلحة بالاندماج في مؤسّسة وطنية واحدة، والقوى السياسية بأنها شريكة في صنع القرار الوطني. إذا لم نفعل ذلك، سيبقى السوريون طوائف، وقبائل، وفصائل مسلحة متناحرة، متنازعة، تستعين بعضها على بعض بالخارج، وهذا نقيض الاستقلال.
ما نريد قوله إن سورية لم تنل استقلالها الناجز بعد، وأن فريقاً سوريّاً واحداً، مهما امتلك من أدوات القوة، لن يمكنه منفرداً مواجهة ما يحول دون ذلك، لهذا نحتاج ورشة عمل كبرى (مؤتمر وطني دائم الانعقاد) يحشد كل الطاقات السورية (داخل سورية وخارجها) من أجل إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، والتحرّر من الفقر والتبعية الاقتصادية، والتغلب على انقساماتنا الداخلية، عبر تكوين إجماع وطني حول شكل الدولة التي نريد ونظامها السياسي العتيد.
العربي الجديد
——————————–
إثنولوجيا الجيران/ شفان إبراهيم
22 ابريل 2025
تأمُل واقع الإنسان السوري الخارج من محنة النصف قرن لحكم الأسد، وما تلاها قرابة العقد والنصف عقد من المقتلة، يدفع للبحث حول مدى فرص إعادة بناء فكرة العيش المشترك.
والإثنولوجيا، علم الأعراق والشعوب، وأحد أفرع علم الإنسان الباحث في أصول الشعوب المختلفة، وخصائصها وتوزعها وعلاقتهم ببعضهم بعضاً ودراسة ثقافاتها تحليلاً مقارنةً، يُشكل أداة مهمة لتغيير الثقافة التي جاءت بها الحرب وتداعياتها. وتُعتبر بين أهم الأدوات في إعادة تعريف العيش المشترك وتفعيله؛ فلا يمكن لأي حضارة أن تفكر بذاتها إذا لم تتوفر لها حضارات أخرى تستعملها للمقارنة والتواصل والبناء عليه. ولنعترف أن خطاب الكراهية نما وتحوّل الى غول يُهدّد حياة السوريون، وأن ثقافة التشفي، وهي هجينة وغريبة عن السوريون بطبيعة الحال، وجدت مكانا ضمن مخيلات كثيرين وعقولهم.
يحتّم السياق السوري الحالي ضرورة التداخل والتوسع في مشاركة إدارة البلاد، ولا يمكن التراجع عنه، فسورية التي تحتوي على عدة هويّات ومجتمعات، تعرّضت جميعها للضرب والتفتيت، وتعمّق الصراع بين الهويّات الفرعية، سواء مع النظام أو مع بعضها بعضاً أيضا، مع استمرار مسرح الصراع الهويّاتي بشكل خفي أو ضمني، بسبب سيولة الخطب “العصماء” التي جاءت بها ألسن “البعث” وأدبياته وأنشطته الداعمة فئات ضد فئات. لتشهد الثورة السورية، تكاتفاً هويّاتياً فريداً، وضربة قاصمة في وجه مخطّطات النظام وداعميه الإقليميين الذين فشلوا في إحداث المواجهات والصراعات الشعبية بين القوميات والأديان. لكن مخلفات الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وسياسيات حكومات الأمر الواقع مع حكومات النظام، ورغبات الاحتقار والتبخيس التي طالت مكوّناتٍ كثيرة، مهدت لسلوكيات العنف والكراهية، وجعلت جميع الهويّات هشّة واكثر انكماشاً، وكلها في خطر مزيد من التفتيت والضرب، ولولا ذلك لكانت سورية من حيث التواصل الفكري والثقافي في ميدان آخر.
يمكن إعادة المجتمع السوري وتأهيله، فهو ذو جذر عميق في الكتّابة والبحث والتفكير، وذو لغات ومعتقدات وفنون وهويّات تُمكنها من لعب أدوار مهمة في أثر الفكر والثقافة والمجتمع، ومن أهم الأفكار والقناعات الواجب تعزيزها في الفكر والعقل والثقافة، أن سورية بلد متعدّد القوميات والأديان والثقافات واللغات، وكُلها تعي وجودها وأهميتها وحقوقها، وتتشابه طموحاتها ومصالحها المشتركة. ويمكن الاشتغال على تأسيس وعي جماعي يتجاوز حالة الرفض والعداء ضد الخصوصيات التي ترسخ عظمة سورية التعدّدية، عوضا عن أفكار اختراق الثقافات ودمجها قسرا، أو تنميط التوجس من الهويات السورية المتعدّدة، عبر إعادة قراءة الإثنولوجيا سورياً، وفق تشكل أكاديمي نخبوي؛ لإعادة صياغة جديدة للمجتمعات بشكل سوي؛ وإزالة جدار العنف والكراهية، مع إمكانية تدريسه في الجامعات والمدارس، ومهمتها الأولى تعزيز أهمية الاختلافات والفوارق وحيويتها وطبيعيّتها، وإيجاد مجتمعات متضامنة مع بعضها بعضاً وحاملة للمفهوم الحضاري السوري.
لنعترف بان العيش المشترك لا يتم عبر ورش عمل نصف يوم، ولا عبر الخطب الرسمية، ولا عبر أهازيج النصر والشعر والنثر، بل يحتاج أساس المساواة والعدالة الاجتماعية والقانون، وهي حقوق أُقرّت للبشرية نوعاً من احترام الإنسانية، وهي تضيع حين تحول ممارسات الحرب والكراهية لموضع ترحيب من القواعد الاجتماعية. فالحرب على الثورة السورية أوجدت حمولة ضخمة من الكراهية والعنف، ولا فائدة في مزيد من الحرب. وإذا كانت آلة الحرب العنصرية التي قادها النظام السوري هي المسؤولة عن ذلك كله، فإن السوريين بعد 8 ديسمبر (2024)، تاريخ سقوط الطاغية، هم المسؤولون عن أي تلاشٍ أو بناء.
العربي الجديد
————————–
العلامة/ يعرب العيسى
22 ابريل 2025
مثل الجميع، بدّلت سورية ألقابها مرّات كثيرة. ففي كل حقبةٍ من عمرها، غلبت عليها صفة ما، مرة بحكم الواقع، ومرّة بحكم رغبة الغرباء، ومرة بمحاولة المتغلّبين فرض إرادتهم عليها، ومرات بحكم اليأس أو الأمل، أو واحدة من عواصف المزاج العام.
فكانت سورية الأموية، سورية العظيمة، سورية العثمانية، سورية الصغيرة، سلّة قمح روما، بلاد الشمس، سورية نصف الفرنكفونية، سورية الأسد، سورية الخبيثة، سورية الطيبة، سورية العنيدة، سورية الثورة، سورية الحرب، بلاد الانقلابات، وهكذا، إلى ما لا نهاية.
وإن كان لي أن أختار لقباً طازجاً، يناسب ملامح وجهها الآن، لقباً يلخصها، فهي اليوم بلاد إشارات الاستفهام. فكل حديث عنها وفيها، إن تحلّى بالحد الأدنى من السلامة العقلية، وأقل درجات المنطق، لا بد أن يكون مبنياً على اللايقين، وعلى الغموض والحيرة والقلق والترقب. من توقعات مصيرها بعد أسابيع، إلى توقعات مصيرها بعد عقود، إلى أصغر أصغر تفصيل فيها.
فلا أحد مثلاً يمكن أن يقول: الحمد لله، صار عندنا وزارة للرياضة والشباب. بل المنطقي أن يقول: هل الوزارة أفضل من الاتحاد؟ ما الذي يريده الرياضيون من وزارة؟ ما الذي ستفعله الوزارة؟ هل ستبقى هذه الوزارة لبضعة أشهر أصلاً؟
وكذلك لا أحد يقول: وفق هذا المسار، فسنصل إلى دستور دائم وانتخابات في تاريخ كذا. بل يتم طرح السؤال مغلفاً بسؤال، ومحاطاً بجملة أسئلة، وبداخله مئات أخرى من الأسئلة.
ذات يوم، كانت مشكلة سورية العميقة، أنها بلاد الإجابات النهائية الحاسمة، البلاد التي لا يطرح فيها أحدٌ أي نوع من الأسئلة على نفسه أو على الآخرين. وقفزت فجأة إلى الاتجاه المعاكس تماماً، فلم يعد أحدٌ يتجرأ على تقديم إجابات من أي نوع، لا أحد يتنطح ليقول رأيه بما حدث أمس، أو يتنبأ بما سيجري في الأسبوع القادم.
اللهم سوى أولئك الطيبون الذين تحكمهم الأهواء، المتحمسون بشدة لإدارة يرونها فوق مستوى النقد، ودون احتمالات القدر، وخارج حسابات السياسة الدولية، أو الناقمون الذين يرون هذه الإدارة واحدة من تلك الأغلاط التي يرتكبها التاريخ في غفلة عن منطقه، ويعيد تصحيحها سريعاً. أولئك وهؤلاء يملكون أجوبة، ويقدمونها بكل شجاعة، لكنها في الحقيقة أجوبة تولد وتنتهي في داخل مشاعرهم ورغباتهم. وستذريها الريح، حين تهبّ الحقيقة.
العقلاء دوماً يطرحون الأسئلة أكثر مما يقدمون إجابات، وفي الحالة السورية اليوم، لا يمكن لعقلٍ أن يقدم جواباً لأي شيء، وبعد أن حيدنا المشاعر والأهواء، لأنها لن تبقى طويلاً، بقي لنا أن نقف في الحيرة. وفي ظلها، وظل الرؤية الضبابية، تصبح العلامة الوطنية اللائقة، هي إشارات الاستفهام.
ألا تلاحظون أننا ننشغل كلنا، وبكلي~تنا، بأي إشارة صغيرة تأتي من أي مكان، ونتناقل تصريحاً لموظف من الدرجة الرابعة في خارجية إحدى الدول الكبرى، أو خبراً من تلك التي تنشرها الصحف المحلية في أسفل ويسار الصفحة التاسعة؟ أتريدون إشارة أشد وضوحاً لحجم حيرتنا؟
أياً كانت المسارات التي رسمها القدر لنا، وسينفذها قريباً، فهي تبدو غائمةً الآن، ولكنها حين تحدُث، سنتمكن سريعاً من فهمها، وسنعرف لماذا جرت، ولماذا جرت هكذا.
حتى يحين ذلك، فلتبقَ أسئلتنا بطول قامة البلاد إذا ما وقفت، وبهدوئها إذا ما نامت، وبهمّتها إذا ما نهضت.
العربي الجديد
————————–
فلتقسّموني… إن قسّمت بلادي/ رباب هلال
22 ابريل 2025
تقسيم؟ فدرلة؟ تقسيم؟ فدرلة؟ لم تكد أصابعي تنزع أربع بتلات من وردة جوريّة حتّى ذبلت، وخزتني شوكتها بقسوة لأسقطها من يدي. سقطت الوردة. ماتت الوردة.
أصوات صخب، تجييش، تشبيح، تخوين، شماتة، تهديد، أحقاد، انتقامات، جهل، غباء، نحيب، عويل، دماء، نزوح، تهجير، استغاثات، فوضى، ضباب، وجنون! والوردة انتحرت. ركعت بجانبها أقسم بأغلظ الإيمان، وبأغلظ آيات القهر والعجز المديديْن، على براءتي من تلويث بتلاتها بالبغضاء. ومن راحة يدي سالت الدماء، فاحمرّ موت الوردة. أيّها الأحمر لمَ لا تلوّن وجنات الحقد القاتل، لعلّه يخجل، فيستكين. لمَ لا تصبغ ضمائر الأغبياء والجهلة من شبّيحة ومحرّضين، وضمائر المتآمرين، لعلّ الوردة تقوم. لعلّ البلاد تكشّ عن وجهها ذباب الضياع، وتهشّ غبار اندثارها المحتمل، لتكفّ عن وخز القلب بحشرجات احتضارها.
منذ عتق وجودنا، ما زال ثمّة ناطقون يرسّمون أنفسهم نيابة عنّا، وباسمنا يتحدّثون، ويقرّرون، نحن فقراء هذه الأرض وملحها المغبّر، ملح نرشّه فوق جراحنا النازفة. لهم المنابر والمسارح، لهم التخمة، ولنا الهباء.
هل ينفع أن أردّد ثانية إنّ هذه الأرض المقدّسة الملعونة لنا جميعاً؟
علّمتني تجارب حياتي العرجاء أن أصفّ لعينيّ الاحتمالات كلّها، ثمّ أبحث في اتساع المابعد لابتسامة انتصار الأمل. إنّما اليوم، تتقاذفني الأحداث بطيشها العجول. تركلني شهوات الشرّ المترعة بالساديّة، بالتواطؤ، والغدر. تصمّني الأبواق الإعلاميّة الملوّثة ببقايا أنفاسنا الوجلة.
من باب اللّاتشاؤم، ومن الدراية بتلقّي الصدمات المعتادة، ومن عجزي المرتعد، ولاحتمال قتلي في عمائنا، أو انتحاري، أكتب وصيّتي لمن يهمّه الأمر.
إن قُسّمت سوريتنا، فلتقسّموني معها، ولتوزّع أعضائي على تراب البلاد:
لدمشق الحياة، حيث رأيت، رأسي. لقلمونها، بنك القلوب الصافية وبذخ الأيادي الخضراء، صدري. لدرعا وحورانها، هناك غطست روحي في يناعة العزّة الوارفة، والكرم الطائيّ. ساقيّ. للسويداء كاشطة الضيم عنّا بأكملنا، من حجارتها السوداء استنشقت رحيق الإباء. كليتيّ. للقنيطرة وجولاننا، بأمّ الحزن والفخر، شاهدت استبسال نزيف الجراح لصون الهويّة. رئتيّ. لحمص العديّة واسطة العقد، فيها عرفت تجسّد الرحمة المكتملة، وفوران الحنان. ذراعيّ. لحماه وريفها سمفونيّة النواعير القديمة، والفداء الشامخ، هناك فهمت كيف يُبستن نقاء الوطن، والأنفة والجود. كبدي. لإدلب، حيث تباركت يديّ بزيتها وزيتونها، وسحرتني حكايات قراها المنسيّة، وسرديّات تاريخ البهاء. بنكرياسي. لحلب الشهباء، مصنع الأصالة والطرب، مصنع الوطن الغنيّ العزيز. ظهري. لشمالنا الفراتيّ والخابور، أذهلتني حنايا الروافد بكنوز أمننا الشاهق؛ ارتوائنا والشبع، دفئنا والنور، وحِنّة الألوان المزدحمة. كبدي. وللساحل السوريّ، الشامخ كجباله، شاسع الصبر والطيبة، الكريم كرم ينابيعه وأنهاره، حقوله والبساتين، والصامد كبحره. هناك مسقط رأسي، طفولتي واليفاعة وبعض شبابي. في بيتنا، لطالما صخب فرح والديّ، باستقبال أصحابنا من الأصقاع السوريّة قاطبة، وعديد من البلدان العربيّة. دفء، كتب، صحف، وحكايات جدّتي العمياء الآسرة. هناك تعلّمت كيف أصيغ هويّتي الشخصيّة المغايرة، كيف أعتز بأنوثتي، وكيف أحلّق خارج السرب، وأطير صوب مستقبلي. وفي غابة من السنديان والبلّوط الشاهقين والرياحين، تحت كثافة اخضرارها الأزليّ، يغطّ الأسلاف والأجداد في نومهم الأبديّ. بين شموخ الأشجار وتواضع القبور، كوّنت فلسفتي الخاصّة بالوجود والحياة. لهناك بكامل قيافة أخضر جباله وأزرق بحره: قلبي.
فليقرأ الملأ ما حفر على شاهدة قبري: “هنا ترقد الأنثى، تحضن خريطة سوريّة الموحّدة، وترانيم بأس عشّاقها الصناديد”.
العربي الجديد
————————–
إعلام أم لايك؟/ شعبان عبود
22 ابريل 2025
قبل أكثر من ثلاثة أشهر، قرّر أحد المؤثرين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي أن يدعو إلى وليمة في الجامع الأموي بدمشق أمام عدسات الكاميرات احتفاء بسقوط النظام، أتى للوليمة جمعٌ من الفقراء والمساكين، ومع الأسف انتهت الوليمة بمقتل عدد ممّن حضروا، نتيجة شدة التدافع وعدم التنظيم. وبدلاً من الفرح بالانتصار على النظام نامت دمشق حزينة ذلك اليوم، ونحن ندرك تماماً أنه لن ولم ينته الجوع في دمشق بوليمة أمام الكاميرات لكنه إغراء “اللايك” الذي لا يُقاوم.
مناسبة العودة إلى هذه الحادثة هي للتأكيد على حجم التأثير الذي بات يلعبه المؤثرون، ويمكن القول هنا إنهم ربما سحبوا البساط من تحت أقدام القادة السياسيين ورجال الدين والفنانين، لقد سرقوا أدوارهم حقاً، الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدرك ذلك فاعتمد على بعضهم.
وفي حالتنا السورية، هناك كثيرٌ مما يُقال عن حضور “المؤثرين” الذي نما ووجد مكاناً له في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، لقد أُفسح المجال لأحدهم من الشبان الصغار أن يجلس على كرسي الرئاسة في قصر الشعب، فيما “مؤثر” آخر لعبَ دور الناطق الإعلامي بمقام الرئاسة وكل الوزارات تقريباً.
الوصول إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون عادة يكون الخطوة الأولى للمنتصرين في الثورات وفي الانقلابات، وذلك لإذاعة البيان رقم 1 وتعريف الجماهير بهويتهم وأهدافهم. لكن ما حصل في سورية يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول ربما يكون المرّة الأولى في التاريخ الذي لم يحصل أن شعر فيه المنتصرون أنهم بحاجة ملحّة لهذا المبنى ولهذه الوسيلة الإعلامية، لقد استعاضوا عن ذلك بوسائل “السوشيال ميديا” والمؤثرين للعب هذا الدور. وإلى غاية هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر لا يزال المؤثرون حاضرين، فيما يحاول الإعلام التقليدي والرسمي أن يقف على قدميه.
كان مؤلماً حقاً لسوريين كثيرين، ومنهم الإعلاميون تحديداً، غياب جهاز إعلامي رسمي خبير ومؤسّساتي ورصين يواكب أهم حدث حصل في تاريخ سورية بعد الاستقلال، غياب مؤلم وغير مفهوم ترك السوريين فريسة للشائعات والخوف ولغباء المؤثرين ولوسائل إعلام لها أجنداتها الخاصة.
لكن ربما أخطر ما عشناه وعايشناه في الأشهر المنصرمة انجرار سوريين كثيرين، وليس المؤثرين وحدهم، لتمرير خطاب طائفي وتحريضي عبر “السوشيال ميديا”، وخاصة منها الخطابات التي تزامنت مع الأحداث الطائفية في بعض المناطق. لم يكترث إلا قلة لوحدة سورية المسكينة، لم ينتبه إلا قلة لكلمات ومصطلحات مثل الوطن وغيره. لقد لاحظنا جميعاً كيف كانت الطائفة تأتي أولاً، وكيف كان هدف حصد مزيد من ” اللايكات” أهم بكثير عند بعضهم من الناس والوطن.
خطورة هذه الوسائل أنها مجانية، وأنها في متناول المليارات، والمادة المنشورة تمتلك قابلية الانتشار العنكبوتي، وتصل إلى الجميع في لحظات قليلة، وخاصة إذا ما حملت مضموناً صادماً أو فضائحياً، أو منتهكاً للخصوصية، وأحياناً لأجل ذلك تماماً.
كذلك، ورغم أهمية وسائل السوشيال ميديا اليوم، لا بد أن نعترف أيضا أنها عزّزت مناخات التطرّف والتشبيح الإلكتروني، وباتت منصة لكثيرين من أصحاب الأجندات الخاصة والأميين والجهلة والطائفيين والعنصريين وحتى الإرهابيين.
بات هؤلاء يستخدمونها ليمزقوا كل من لا يتفق معهم بالرأي، ويطالبوننا بأن نشاطرهم آراءهم العنفية والمتطرفة والفظة، أو ينشرون صوراً لا تحترم الذوق العام أو القيم العائلية والاجتماعية أو يرسلوها لنا عنوةً.
ذلك كله يجعل مهمة إعادة الاعتبار لوسائل الإعلام التقليدية صعبة للغاية، لكن في بلد له وضع خاص مثل سورية، ربما يجب أن تكون هذه المهمة أولوية الأولويات.
العربي الجديد
—————————-
الجدّ… عيون بابا عمرو وطفلها العنيد/ خالد أبو صلاح
22 ابريل 2025
في مدينة تحولت إلى خريطة للدم وتضاريس للوجع، حيث كل زاوية في حمص تحمل قصة وذاكرة واسم شهيد، كان هناك رجل يسير بين الأنقاض كما لو أنه يعرف أين يضع قدمه. علي عثمان، أو كما كنا نناديه بمحبة وإكبار “الجد”، لم يكن عجوزا كما يوحي اللقب، بل شابا بروح طفل وشجاعة ثائر عنيد، يركض في قلب الخطر، يسابق الموت ويبتسم له في لعبة القدر.
عرفته حين كانت الثورة في البدايات المرتبكة، في مدينة مفككة بالحواجز، متماسكة بالأمل. التقيته في مظاهرة مرتجلة، يقود “سوزوكي” صغيرة، بين الرصاص لينقل الجرحى. لم يكن يعرفني، لكنه قال لي: “اركب… بسرعة”.. كانت تلك أولى جمل صداقتنا. منذ ذلك اليوم، صار علي رفيق الطريق تحت القصف والنار، في لحظات اللعب مع الموت والحظ، وفي أيام الملاحقة التي لا تنتهي. لم يكن يملك سلاحاً، لكنه قرر أن يحمل الكاميرا، وتعلّم كيف يصوّر. اقتحم الخطر، لا حبّاً في المجازفة، بل لأن الصورة، في تلك الأيام، كانت سلاحاً نادراً، وضروريّاً، وأخطر من الرصاص.
نشأ علي في بيت يشبهه: بسيط، لكنه شديد الاعتداد بكرامته. والده، محمود عثمان، محاسب عسكري خدم 35 عاماً، وخرج نظيف اليد والسمعة، رجلٌ لم تنل منه وظائف الدولة ولا شبكاتها. ووالدته، آمنة، من قرية القنية بريف درعا، مزيج من صلابة الأرض التي تنبت من دون إذن، ودفء الأم التي تربّي على الصدق لا السلامة. كانت عائلة لا تُعلّم أبناءها الطاعة، بل تُعلّمهم المسؤولية. وكانت الثورة، حين اندلعت، كأنها خرجت من ضلوعهم.
تربى في بيت يعجّ بالحياة، ويضجّ بالأسماء. عمل في المطاعم، ثم في أسواق الخضار، أحبّ الرياضة واحترف الكاراتيه، وسافر بحثاً عن رزقه بين حمص والسعودية. حياة عادية لرجل غير عادي. كانت الثورة هي الحدّ الفاصل الذي كشف ما بداخله. ليصبح لاحقاً أيقونة للثورة تردّد اسمها بيانات وزارية للدول العظمى، وكبرى الصحف والمجلات.
حين اشتعلت حمص، كان حي بابا عمرو أول الشهداء وأول الشهود. كتاباً مفتوحاً للرصاص، والمركز الإعلامي هناك لم يكن غرفة عمليات، بل غرفة ضمير. لا تمويل، لا تجهيزات، فقط قلوب مصممة على ألا تترك الصمت ينتصر. وصار علي، بعينيه الثابتتين وصوته الواضح، عين بابا عمرو وطفلها المدلل. وسرعان ما تحوّل المركز إلى قبلة للصحافيين من كل العالم، يتحدّى نظام الأسد ويعري وجهه القبيح كما لم يفعل أحد.
في قلب المركز، تماهى علي الإنسان بالصحافي. يبتسم حين يتوتر الآخرون، ويخشى على رفاقه، حين قُصف المركز الإعلامي، صاح: “أطفئوا البث… كشفوا المكان”. يحذرهم كي لا يقتلهم الضوء. وكأنه يزن الصورة بميزان الدم. وكان، على نحو يُربكك، أباً لخمسة أطفال. كيف يمكن لرجل يعرف تماماً ماذا يعني أن يُيَتَّم طفل، أن يواجه الخطر بهذا العناد؟ وحدهم الذين يحبون جداً، يخاطرون جداً. قال لي مرة: “يمكنك أن تحب حدّ أن تختبئ، أو أن تحب حدّ أن تواجه… وأنا اخترت الثانية”.
حاز علي على صداقة وثقة الصحافيين الدوليين. كان دليلهم وراويتهم، ومسعفاً لبعضهم. في إحدى الليالي، بول كونروي، الصحافي البريطاني المخضرم، الذي عاش ثلاثة عقود بين الحروب والمناطق الساخنة، قصّ علينا حكاياته عن بنغازي الليبية، عن الرعب الذي شهده، وعن الدمار الذي لا يُقارن. إنسان يشع بالفكاهة، يروي الحكايات وكأنها محض ذكرى بعيدة عن واقع اليوم. ولكن علي، بابتسامته الهادئة التي لا تفارق محيّاه، ردّ: “انتظر يا صديقي، وسترى وجهك بعد أيام، وستشعر بما لا يمكن أن تراه إلا هنا”. وما هي إلا أيام قليلة، حتى فوجئ بول بالقصف السجادي العنيف، كنا محاصرين في الطابق السفلي من المركز الإعلامي، في غرفة صغيرة تفوح منها رائحة الموت، والذعر، ومحاولة الفرار خارج هذه اللحظة التراجيدية. وسط تلك الفوضى، بصوت مختنق وهو يراقب الجرحى، قال بول: “أتعلم، كنت أظن أنني أعرف الحرب، لكنني اليوم أكتشف أننا لا نعرف شيئاً عن الموت”.
عندما قُتل الصحافيان ماري كولفن وريمي أوشليك في قصف المركز ، كان علي يحمل الكاميرا بيد، والأشلاء بالأخرى. لم يتوقف ليبحث عن المسؤول، كان يعرف. فقط التقط الصورة، كي لا يقول أحدٌ لاحقاً: “لم نرَ شيئاً”.
وبعد المجزرة الكبرى في بابا عمرو نهاية فبراير/ شباط 2012 وتهجير أهلها بالموت لا بالباصات الخضراء، بقي علي متخفياً في حي مجاور، ثم خرج إلى ريف حلب الشمالي. وفي 28 مارس/ آذار 2012، تم استدراجه عبر هاتف صديقة اعتُقلت، فوقع في الفخ. اعتقله النظام، وظهر على شاشته الرسمية، بملامح هائمة يُدلي باعترافات باهتة، لا تشبهه. عيناه تصرخ بما لم يقله لسانه. كأن روحه تنظر من خلف الشاشات تقول: هذا ليس أنا، هذا جسدي تحت التهديد، أما أنا فقد قرّرت أن أبقى معكم، بالكاميرا، بالنداء، بالصورة التي لن يحذفها أحد أو يستطيع التلاعب بها.
وقف العالم يراقب. تصريحات من هيلاري كلينتون، من ويليام هيغ، ومن كبرى المنظمّات الصحافية. عرفوا أن هذا الرجل الذي حمل الخضار يوماً، وأصبح يحمل الحقيقة، صار ذاكرة الثورة. لم يكن علي مهمّاً لأنه يحمل كاميرا فقط، بل لأنه صار دليلاً حيّاً على ما حاول النظام دفنه وطمسه.
وبعد عام ونصف على اعتقاله، سُجلت وفاته في السجل المدني، دون سبب، أو محاكمة، من دون حتى جثة، رغم ظهوره على إعلام الدولة الرسمي.. هكذا ببساطة، مات علي على الورق. لكن الورق لا يعرف كيف تموت الأرواح العظيمة. لاحقاً، في صور “قيصر”، تعرّفت عائلته عليه بين آلاف الجثث التي قضت تحت التعذيب والتجويع. كان ذلك هو الاعتراف الرسمي الدامغ.
لم يمت علي. لأن الذين يصنعون ذاكرة لا يموتون. بقي في الصور، في الوثائق، في كل بث حيّ حمل صوته. بقي في ذلك الشريط الذي صرخ فيه: “بابا عمرو تُقصف… أين أنتم يا عرب؟”. بقي في ضحكته التي كان يخبئ بها خوفه كي لا يخيف أصدقاءه.
فيما بعد، استشهد ثلاثة من إخوته: حمزة الذي ورث كاميراته، عبد الكافي، فإبراهيم. علي لم يرَ موتهم، لكنه عرف أن القصة أطول من حياته، وأن الطريق لا يُقاس بخطواته وحده.
الثورة التي أحبها لم تُهزم. بل انتصرت حتى قبل الثامن من ديسمبر/ كانون الأول (2024)؛ منذ الصرخة الأولى، في قلوبنا، في الأثر، في الصورة التي التُقطت رغم الخطر، في الصوت الذي ارتجف لكنه نطق. الأسد سقط يوم ارتعد من كاميرا علي، وارتبك من حضور شابٍ يعشق الحياة ويصر على روايتها.
في آخر مرّة تحدثنا، قال لي: “إذا متُّ، لا تزعل… احكي قصتي صح، بدون دراما”. وها أنا أفعل، بلا مبالغة، بكل ما في الذاكرة من وجع مؤجّل، وألم تخثر طوال أربعة عشر عاماً. وها أنا أفعل، لا لأبكيك، بل لأُعيدك إلى حيث تنتمي: في ضمير من عرفوك، وفي وعي من سيقرأون عنك.
علي مات، نعم. لكنّه لم ينتهِ. لأن القصص الحقيقية لا تنتهي. لأنها تُروى، وتُكتب، وتُتداول، وتُزرع في صدور من لم يعرفوه فيحلمون مثله، ويعاندون الواقع مثله، ويبتسمون للوجع كما كان يفعل.
سلام عليك، يا جدّو الثورة
سلامٌ على عينك التي لا تنام، وعلى صوتك الذي لم يختنق تحت التعذيب.
سلامٌ عليك يا من كنت أكبر من الكاميرا، وأصدق من كل بث مباشر.
سلام على ظلّك الذي ما زال واقفاً عند مفترقات الموت، لا يرتجف، ولا يتراجع.
سلام على نظرتك الثابتة التي برهنت أن الحقيقة لا تُهزم، حتى لو غُيّب حاملها.
سلام على روحك التي ما زالت تتنفس في كل صورة نجت، وفي كل حكاية لم تُدفن.
سلامٌ على عيون بابا عمرو، التي كنتها… وستبقى.
العربي الجديد
—————————–
لماذا اُختير الشرع ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم؟/ محمود علوش
22/4/2025
شهد الشرق الأوسط، منذ مطلع الألفية الثالثة، سلسلة من الأحداث الكبرى التي أعادت تشكيل معالمه الجيوسياسية، وأنظمة الحكم في بعض دوله، والسياسات الدولية في المنطقة.
يبرز سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كأحد أهم هذه الأحداث. هذا الحدث لم يُنهِ فقط أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد وحزب البعث، ولم يُحدث هزة جيوسياسية إقليمية فحسب، بل جلب إلى السلطة شخصية استثنائية، هي أحمد الشرع، الذي غيّر سوريا وتغير معها.
لذا، لم يكن مفاجئًا أن تختار مجلة “تايم” الأميركية الشرع ضمن قائمة أكثر مئة شخصية سياسية عالمية تأثيرًا لهذا العام.
تستند معايير “تايم” في تصنيفاتها السنوية إلى التأثير القيادي، والتغييرات الملموسة التي يُحدثها الأفراد على بلدانهم والمنطقة والسياسات الدولية. تنطبق هذه المعايير على أحمد الشرع، لكن اختياره هذا العام يحمل دلالات تتجاوز المعايير التقليدية.
فهذه هي المرة الأولى التي تُدرج فيها المجلة شخصية ذات خلفية إسلامية سابقة ضمن قائمة الزعماء المؤثرين عالميًا. على سبيل المثال، أدرجت “تايم” بشار الأسد في عام 2013 ضمن الشخصيات المؤثرة لقيادته بلدًا في خضم صراع جيوسياسي كبير عليه، لكنه لم يمتلك خلفية مشابهة للشرع.
من ناحية أخرى، يُسلط اختيار الشرع الضوء على اهتمام العالم بمساعيه لتجاوز الماضي وإثبات قدرته على إدارة سوريا وتوحيدها وبناء دولة جديدة، وعلى التعامل مع التحديات الجيوسياسية التي تجذب العديد من الفاعلين الإقليميين والدوليين.
تعتمد “تايم” في تصنيفها على معايير التأثير العالمي والإنجازات التي تغيّر الأحداث أو السياسات أو المجتمعات، سواء كان هذا التأثير إيجابيًا أو سلبيًا.
يُبرز تصنيف الشرع جهوده الدعائية لتقديم صورة جديدة عنه للعالم. منصات مثل “تايم” لا تكتسب أهميتها من مصداقيتها فحسب، بل من تأثيرها على نظرة صانعي القرار في العالم للتحول السوري.
وفي معرض تفسير اختيارها، وصفت “تايم” الشرع بأنه يوازن بين المتشددين الذين قادهم سابقًا، والليبراليين السوريين الذين رحبوا بسقوط الأسد، مشيدةً بتجربته في حكم شمال غرب سوريا وتواصله مع الأقليات الدينية في المنطقة.
هذا التصنيف يروّج للشرع كزعيم سوري يطمح لقيادة بلاده مع مراعاة تنوعها الديني والعرقي والثقافي، وتأثيرها الإقليمي الكبير. وعلى الرغم من أن معايير “تايم” لا تسعى بالضرورة لإضفاء طابع إيجابي أو سلبي على الشخصيات العالمية، فإن تصنيف الشرع يميل إلى الإيجابية، بالنظر إلى التحول الكبير في شخصيته منذ توليه السلطة في سوريا.
كانت صورته مثيرة للجدل في الأوساط الدولية حين تولّى قيادة هيئة تحرير الشام، إذ ارتبط اسمه آنذاك بمشاريع عابرة للحدود أثارت كثيراً من التحفظات. لكن مع مرور الوقت، أعاد تموضع رؤيته لينخرط في مشروع سوري الطابع، يركّز على الأهداف المحلية للثورة، وعلى رأسها إسقاط النظام القائم، الذي ترسّخ عبر القمع والاستبداد والبنية الطائفية.
كونه الشخصية العربية الوحيدة في فئة القادة ضمن قائمة “تايم”، إلى جانب شخصيات عالمية مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، يعزز التصنيف مكانة الشرع كرمز للقيادة العربية المؤثرة عالميًا.
ويعكس التصنيف أهمية التغيير الذي قاده في سوريا على محيطَيها العربي والإقليمي، وعلى المصالح الدولية في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، يشير التصنيف إلى تحول في السردية الدولية تجاه الثورة السورية، من تصويرها كصراع أهلي طائفي أدى إلى عودة خطر الإرهاب، إلى الاعتراف بها كحركة أحدثت تغييرًا جذريًا، وخلقت فرصة تاريخية لتحويل سوريا من معضلة مزمنة إلى قيمة جيوسياسية تدعم استقرار المنطقة وتتماشى مع المصالح الغربية.
وفي ضوء ذلك، يُمكن النظر إلى تصنيف “تايم” على أنه مؤشر إضافي على التقبل العالمي المتزايد لحقيقة أن الشرع لديه طموحات تستحق الاعتراف بها وبحاجة إلى فرصة لإثبات نواياه وحقيقة اعتداله.
أسهم الصراع في سوريا في تشويه النظرة الدولية إلى الواقع السوري بشكل كبير. فقد قامت هذه النظرة، في الغالب، على مجموعة من التصورات التي أضرت بالثورة السورية وبسياسات المجتمع الدولي تجاه سوريا.
من ذلك، على سبيل المثال، التركيز المبالغ فيه على البعد الطائفي للثورة على حساب الأبعاد الاجتماعية العميقة التي دفعت الشعب السوري للانتفاض ضد نظام بشار الأسد، فضلًا عن إغفال الأبعاد المحلية للصراع لصالح الاعتبارات الجيوسياسية.
بعد الإطاحة بنظام الأسد، تسعى العديد من الدول الغربية إلى تجاوز هذه التصورات، أو على الأقل الحد من تأثيرها كمحدد رئيسي لسياساتها تجاه سوريا. وتعمل هذه الدول على إعادة توجيه جهودها نحو دعم سوريا في انتقالها نحو بناء دولة جديدة، مع ضمان عدم عودتها إلى دوامة الصراع.
غير أن الاعتبارات والتحفظات السائدة تجاه الشرع ما تزال تُسهم في تقييد توجه عدد من الدول الغربية نحو اعتماد سياسة أكثر انفتاحًا ومرونة حيال الواقع السياسي الجديد.
في هذا السياق، يمكن أن يسهم تصنيف مجلة “تايم” بشكل جزئي في تبديد هذه النظرة الحذرة، وتشجيع المجتمع الدولي على التركيز على الفرص التي توفرها قيادة الشرع لسوريا، بدلًا من التركيز على المخاوف.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
باحث في العلاقات الدولية
الجزيرة
———————————–
نحو ثورة اجتماعية/ مصطفى قداد
2025.04.23
لقد شكَّلت الثورة السورية لحظةً فارقةً في التاريخ الحديث، ليس كونها حركةً ضد الاستبداد فحسب، بل لأنّها كشفت عن أزمات بنيوية في النسيج الاجتماعي والسياسي. فخلال عقود من الحكم الشمولي، تم تفكيك مؤسسات الدولة لصالح شبكات المحسوبية والطائفية، مما أدى إلى تآكل مفهوم المواطنة، وانزياح الهويّة الوطنيّة لصالح انتماءات ضيّقة.
واليوم، وبعد الإطاحة بالنظام البائد، يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن تحويل النّصر العسكريّ إلى مشروع وطنيّ شامل؟
فبعد انتصار الثورة السياسية والعسكرية، وانهيار النظام الاستبدادي المُتجذِّر في سوريا، تقف سوريا على أعتاب مرحلة مصيرية تتطلب منها تحويل الزخم الثوري إلى مشروعٍ تأسيسي يعيد بناء الدولة وفق عقدٍ اجتماعيٍ جديد، هذا المشروع يجمع بين شرعيتين أو سمتين هما:
الثورية: أي تمثيل الإرادة الشعبية المنتفضة ضد كل مخلفات النظام البائد.
والثقافية: أي موافقة القيم الثقافية الإسلامية والإنسانية المشكلة للمجتمع السوري مراعية التنوع العرقي والإثني لهذا المجتمع.
إن الانتقال إلى مرحلة البناء ليس مجرد تسويةٍ سياسية سطحية فحسب؛ بل هو ثورةٌ ثانية تُعيد هندسة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين عناصر المجتمع ذاته أيضاً؛ لذا تبرز لدينا آليات متعددة يمكن أن تشكل حجر الأساس في هذه العملية الثورية.
العقد الاجتماعي الجديد..”بين المرجعية الدينية والشرعية الدولية”
إن محاولة الفصل بين السياق الديني والدولي في أثناء عملية إعادة بناء المجتمع السوري غير منطقية البتّة؛ بل على العكس يجب الاستفادة من هذا التلازم بينهما. فمن ناحية، تُشكّل الشريعة الإسلامية – كمصدرٍ تشريعيٍ وثقافيٍ – إطارًا مرجعيًا لأكبر شرائح المجتمع السوري، مما يمكننا من الاستناد إليها خاصةً في ظل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُؤسس لمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي، ويظهر هذا المعنى جلياً في كثير من آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ” (النحل:90)، وغيرها من النصوص التي تؤسس لمفاهيم العدل والإحسان والتماسك المجتمعي التي نحتاج إليها في إعادة بناء المجتمع السوري الجديد، مما يجعل قضية الاستناد إلى هذه المرجعية الدينية ضرورة ملحة.
وبكل تأكيد هذا سيؤدي بالضرورة إلى توافق العقد الاجتماعي الجديد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات والقوانين الدولية التي نجد انسجام معظمها مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ لذا فالدستور الجديد يجب أن يجسّد توازنًا دقيقًا بين الهوية الإسلامية الجامعة وضمان الحقوق الفردية والجماعية للمكونات، وفقًا للمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصية الثقافية، في ظل التنوع الديني والعرقي الذي تتمتع به سوريا.
خمس ركائز لإعادة البناء..”نحو نموذج سوري مستدام”
أولاً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية:
“هذا المسار لا يهدف إلى الانتقام بقدر ما يسعى إلى إعادة الثقة المفقودة بين أفراد المجتمع”
تأتي هذه الركيزة على رأس سلم الأولويات؛ فلا بد من إنشاء آلياتٍ قانونيةٍ مستقلةٍ لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وتعويض الضحايا، ولكن هذا أيضاً يجب أن يترافق مع حوار وطني شامل ومستمر يضم كل الأطياف، بما في ذلك ممثلون عن المناطق غير الموالية للدولة الجديدة وذلك بغية تفكيك خطاب الكراهية وإعادة بناء الثقة بين جميع المكونات.
فمما لا شك فيه أن محاسبة رموز الفساد ومرتكبي جرائم الحرب مع تعويض الضحايا، وتبني آليات لتحقيق ذلك يلعب دوراً هاماً ومحورياً في رأب الصدع الحاصل في البناء الاجتماعي، مع تبيين أن هذا المسار لا يهدف إلى الانتقام بقدر ما يسعى إلى إعادة الثقة المفقودة بين أفراد المجتمع، وتعزيز دور الدولة الجديدة على أنها الضامن المجتمعي والقادر على المحاسبة وحفظ الحقوق وكذلك منح الأمن والعدل.
كما أن النماذج التاريخية للحالات المشابهة تظهر لنا أهمية هذه الخطوة كنقطة انطلاق لمشروع بناء الدولة الجديدة بعد الحروب المدمرة والأزمات، كما حصل في ألمانيا وراوندا.
ثانياً: الدولة وسيادة القانون:
“من خلال دولة القانون والمواطنة نعيد بناء ملكية المواطن لوطنه
وننمي لديه الشعور بالمسؤولية عن هذه الدولة”
ويمكن تحقيق ذلك من خلال دستورٍ يُرسّخ مبدأ المساواة أمام القانون، ويضمن استقلال القضاء، ويُحارب الفساد من خلال هيئات رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة، مدعومة بتقنيات وآليات لتعزيز الشفافية.
لأن بناء دولة القانون يعدُّ من أهم الأمور التي يُعوَّلُ عليها في رفع أعمدة الدولة الجديدة عالياً وبقوة، مما يؤهلها لكسب ثقة مواطنيها جميعاً، ويعمل على ردم الهوّة بين عناصر المجتمع من خلال دستور عصري يُوازن بين الهوية الإسلامية التي تمثل الشريحة الأوسع من المواطنين مع ضمان حقوق الأقليات وحفظ خصوصياتهم الدينية والثقافية بما لا يتعارض مع النظام العام للدولة أو مصالحها العليا.
فمن خلال دولة القانون والمواطنة نعيد بناء ملكية المواطن لوطنه، وننمي لديه الشعور بالمسؤولية عن هذه الدولة مما يعزز دوره في بنائها والحفاظ عليها وكأنها ملكه؛ لأنها تحافظ بقانونها على كينونته التي لا تنفصل عنه؛ فيصبح الوطن بيته الكبير الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة لتنميته والحفاظ عليه.
ثالثاً: الاقتصاد التشاركي والعدالة الاجتماعية:
“لأنه يعزز قضية التكافل الاجتماعي ويحارب البطالة ويعمل على تقليص الفروق بين شرائح المجتمع”
بما أن الاقتصاد هو العصب في قيام الدولة فلا بد من بنائه بشكل دقيق ومحكم؛ يضاف إلى ذلك تبني سياسات تضمن التوزيع العادل للثروة، مثل فرض الضرائب التصاعدية التي تراعي دخل الأفراد، ودعم المشاريع التعاونية والتشجيع عليها والتي تعكس روح التكافل الاجتماعي في المجتمع وتعيد له تماسكه المنشود.
فبعد سنوات طوال من احتكار النظام البائد للثروة ومصادرها، نجد أنفسنا بحاجة للعمل على إعادة توزيع الثروة بشكل عادل وشفاف، وبناء اقتصاد إنتاجي قائم على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ يمول عبر تأسيس صندوق سيادي مشترك تضخ فيه الأموال من قبل المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمنظمات ويضاف إليها أيضاً الأموال المُستردة من المجرمين والفاسدين، مما ينشط العجلة الاقتصادية ويعزز قضية التكافل الاجتماعي ويحارب البطالة ويعمل على تقليص الفروق بين شرائح المجتمع.
رابعاً: التعليم والإعلام كأدوات للتغيير:
“لأن التعليم المتقن هو الجسر الذي يمكننا من تجاوز الهوة التي خلفها النظام البائد ويصلنا بالمستقبل المنشود”
يمثل التعليم ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، حيث يسهم في تشكيل وعي الأفراد وتوجيه سلوكهم وفقًا لقيم معينة. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى التعليم كأداة تغيير على مستويين رئيسيين:
أ- تعزيز قيم المواطنة المسؤولة:
ويتطلب ذلك إعداد مناهج دراسية تعزز قيم المشاركة المجتمعية، والانتماء الحقيقي للوطن، إضافة إلى العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان، وتعمل على تشجيع التعليم والنقد البناء والتفكير التحليلي، مما يساعد على مواجهة الأفكار المتطرفة أو الإقصائية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة التي تركز على الحوار والانفتاح والتسامح.
ب- ربط التعليم بسوق العمل والتحديات المجتمعية:
وذلك بالعمل على تطوير المناهج لتكون أكثر ارتباطًا بواقع المجتمع واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على التعليم المهني والتقني جنبًا إلى جنب مع التعليم الأكاديمي لضمان فرص اقتصادية عادلة ونهضة سريعة.
هذا التعليم المتقن يجب أن يترافق مع إعلام حر وفاعل مواكب لكل التحولات السابقة بمختلف أشكالها، وتنسيق دوره كأداة رئيسية في تشكيل الرأي العام الجامع والموحد لشرائح المجتمع كلها؛ لذا يجب أن يتسم بسمتين هما:
أ- إعلام حر ومهني:
الإعلام المهني يهدف إلى نقل الحقيقة، والتحليل المتوازن، وتقديم مساحة للنقاش العام؛ لذا يجب أن يكون هناك استقلالية للإعلام عن أي أجندات ضيقة أو مصالح سياسية آنية قد تضر بالمصلحة العامة، والسعي لتطوير قوانين ومواثيق أخلاقية للإعلاميين ولمستخدمي وسائل التواصل تحدُّ من انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي تستهدف وحدة المجتمع.
ب- مواجهة الخطاب الفئوي والمتطرف:
إن وسائل الإعلام يمكنها أن تؤدي دورًا كبيرًا في الحد من الانقسامات الاجتماعية عبر تعزيز لغة الحوار والتفاهم، والتركيز على تعزيز خطاب الاعتدال وإعطاء مساحة أكبر للأصوات الداعية إلى التعايش السلمي.
كما أن دور وسائل التواصل الاجتماعي كرديف لأجهزة الإعلام الرسمي في وقتنا الحالي يدفعنا لضمها كآلية مهمة في استراتيجيات الحوار الوطني وخاصة مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ لم يعد من الممكن تجاهل دورها في التأثير على الأفراد والمجتمعات لذا يجب:
أ- إطلاق مبادرات رقمية للحوار المجتمعي
إذ يمكن للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية استثمار المنصات الرقمية لنشر النقاشات البناءة حول القضايا الوطنية، كما يجب أن توفر هذه المنصات مساحة للحوار المفتوح بعيدًا عن الرقابة المفرطة التي تضر بالصِّدقيَّة.
ب- مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز الوعي الرقمي
وذلك بتشجيع الأفراد على التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو مشاركتها، وإنشاء برامج تدريبية لتعليم الشباب كيفية التعامل مع المعلومات بشكل نقدي وذكي.
نتيجة لكل ما سبق فإن التكامل بين التعليم والإعلام أمر مهم جداً لتحقيق تغيير حقيقي ومستدام، فلا بد من تنسيق الجهود بين قطاعي التعليم والإعلام، بحيث يعملان معًا على بناء مجتمع أكثر وعيًا وانفتاحًا ومسؤولية، مع استثمار أدوات العصر الرقمية لتعزيز هذه الجهود.
خامساً: السياسة الخارجية المتوازنة
“ألمٌ وأمل: دروس من التجارب الدولية”
تبقى السياسة الخارجية للدولة الجديدة المهمة الأهم من جهة كسب الاعتراف الدولي وتأمين انخراط الكيان الجديد في عجلة المنظومة الدولية، كل ذلك يستدعي أن تقوم سوريا بتبني سياسة خارجية قوامها عدم الانحياز، والتعاون مع دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية لضمان دعمها في عملية إعادة الإعمار، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم تكرار السيناريوهات والأخطاء التي قد تجر ويلات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.
إذ إن سوريا تواجه تحدياتٍ جسيمةً، فالإرث الثقيل للصراع الدامي الذي خلف أكثر من مليوني شهيد وقتيل ومفقود وخمسة عشر مليون مهاجر، وما يرافقه من تداعيات سلبية نفسية واقتصادية واجتماعية. كما أن التنافس الجيوسياسي الحاصل بسبب موقعها الاستراتيجي وتنازع مصالح القوى الدولية والإقليمية في هذه المنطقة يستوجب الحذر في الخطوات التي ستقدم عليها كيلا تسبب تعكراً في مزاج القوى المتنافسة في المنطقة؛ مما يوقعها في أزمات جديدة خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار وبناء التحالفات الجديدة. ويعد الأهم من ذلك كله الانقسامات الداخلية إذ تعد قضية استمرار الولاءات الفرعية (الطائفية والعشائرية)، وارتباطها بولاءات خارجية وتقديمها على الولاء الوطني العام من أصعب الأزمات التي تحتاج إلى جهود حثيثة لكسرها؛ لأنها في غالبها مرتبطة بالموروث الثقافي والاجتماعي والنفعي مما يجعل مهمة القضاء عليها أمراً شاقاً.
إلا أننا مع كل التحديات السابقة وجدنا في صفحات التاريخ دروساً مملوءة بالأمل والتفاؤل؛ فتجارب الدول الأخرى ما بعد الحرب تثبت أن إرادة الإصلاح قادرة على تحويل المآسي والتحديات إلى دوافع إيجابية قوية. وسوريا اليوم بموقعها الاستراتيجي وثرواتها البشرية، قادرة على أن تصبح نموذجًا جديداً في التاريخ ومثالاً للنهوض من الركام، شريطة أن تتبنى رؤيةً واضحةً تجمع بين الأصالة والحداثة.
“نحو سوريا جديدة”
ختاماً، (نحو ثورة اجتماعية) ليست شعارًا نترنم به فحسب، بل هي عملية معقدة تحتاج إلى إرادة سياسية وشعبية، وخطة استراتيجية تعالج جذور المشكلات والأمراض لا النتائج والأعراض. وإنَّ نجاح هذه الثورة الاجتماعية مرهون بقدرة النُّخب السورية على تجاوز الانقسامات، وبناء تحالفات واسعة تعكس تطلعات الشعب، مع الاستفادة من الخبرات الدولية من دون فقدان الخصوصية.
وإن هذا التحول المنشود لا يتحقق إلا بقيادةٍ نخبويةٍ واعيةٍ ترفض إغراءات الانتقام والثأر، وتتبنى رؤيةً تشاركيةً تدمج المجتمع المدني والدولي في عملية إعادة البناء، مستفيدةً من دروس التاريخ: فـألمانيا ما بعد الهزيمة لم تنهض إلا بالاعتراف بجرائمها من خلال محاكم نورنبرغ، ورواندا حوَّلت المأساة إلى نموذجٍ للتعايش؛ لذا فإن الثورة الاجتماعية المطلوبة ليست خيارًا، بل هي الضامن الوحيد لبناء الدولة القوية وعدم عودة الاستبداد بأقنعة جديدة، هي ثورة اجتماعية تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتستند إلى رؤيةٍ واضحةٍ تعالج الإرث المزدوج للاستبداد والحرب.
لعلنا بهذه الرؤية نتمكن من تحويل بلدنا الحبيب سوريا من دولةٍ مُنهكةٍ بالصراعات إلى دولة قوية عادلة مزدهرة، تُقدم للعالم نموذجًا جديداً يُثبت أن القيم الإسلامية والأسس الدولية ليستا متناقضتين، بل هما وجهان لعملة واحدة تمثلان: العدالة والحرية.
تلفزيون سوريا
—————————-
إعادة دمشق إلى النور.. دعونا نعمل على أن تصبح “عاصمة متوسطية للثقافة والحوار”/ خالد العظم و علي وانلي
2025.04.23
تشكّل مبادرة “العواصم المتوسطية للثقافة والحوار” فرصة ذهبية لإعادة دمشق، أقدم عاصمة مأهولة، إلى النور، عبر تجديد حضورها في محيطها الأورومتوسطي، واستقطاب الفعاليات الثقافية والحوارية المدنية الإقليمية.
بالتوازي، أعلنت بلدية قرطبة الإسبانية، المدينة التوأم لدمشق منذ عام 2002، عن نيتها الترشّح للقب العاصمة الشمالية لعام 2027.
وفي حال تقدّمت دمشق بملف مشترك مع قرطبة، وهو أمر ممكن، فستحمل هذه الخطوة وقعًا إقليميًا إيجابيًا، لما يجمع المدينتين من إرث حضاري مشترك، وفرصة لإعادة تعبيد الجسور مع أوروبا، ولِما قد تمثله هذه التسمية من انطلاقة لتحديد سوريا مجددًا على الخريطة الثقافية والفنية الدولية.
دعونا، بدايةً، لا نخشى هذا المسار، فالسوريون وأصدقاؤهم في الخارج، أفرادًا وكيانات، متعطشون لإيجاد الفرصة لدعم البلاد، وهذه التسمية ستمثل دعوة عامة دولية للترحيب بالجميع في دمشق للعمل والحوار.
نعم، تتعاظم التحديات التي تواجهها محافظة دمشق، والوزارات المطلوبة لمساندة عملية التسمية؛ الثقافة، والسياحة، والإدارة المحلية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية التي يجب أن ترعى رسميًا مسار عملية التقدّم. لكن هذا الطلب، لو أُدير بشكل جيد، لن يُلقي بالأعباء على الإدارة المحلية وحدها، فالكيانات الأورومتوسطية الحكومية والمدنية، التي شاركتنا معاناتنا بشكل مباشر أو غير مباشر، تقف حائرة الآن أمام إيجاد الدعوة السليمة من دمشق للعمل المشترك، وهي تملك كل المؤهلات للتدخل على كل الأصعدة، وهذه الدعوة العامة ستنظم الجهود في هذا الصدد.
ما يدركه محيط سوريا الرسمي والمدني هو أن ما تشهده بلادنا اليوم لَهُو فرصة تاريخية تسهم في كسر توازنات قاتلة بُنيت عليها منطقتنا لعقود طويلة، وكل صانع للسلام والازدهار والتنمية يرنو إلى أن يكون له يد فيها. دعونا نستثمر ذلك بذكاء.
ما لِدمشق في التسمية؟
تتيح تسمية “العاصمة المتوسطية للثقافة والحوار” لدمشقنا الحبيبة مكاسب عظيمة: سياسية، وثقافية، ومدنية، واستثمارية.
سياسيًا، تمنح التسمية سوريا قوة ناعمة في الساحة الأورومتوسطية، في وقت نحتاج فيه إلى استثمار إرثنا الثقافي والحضاري كأداة قوة لهويتنا الخارجية. وتمتاز هذه القوة الناعمة بأنها تعمل بعيدًا عن الاشتراطات السياسية التقليدية، وتواجه كل هواجس العزلة.
كذلك، تعبّر التسمية عن رسالة الإدارة الجديدة للخارج بشأن إرادة حقيقية للاستقرار والتنمية بعيدًا عن أشباح الصراعات الداخلية والخارجية.
ثقافيًا، ربما من الصعب حصر المكاسب العظيمة لهذه التسمية إن أُحسن استثمارها. رغم كل المحاولات الفردية والجماعية لبناء المشهد الثقافي التعددي السوري منذ الاستقلال وتأسيس الدولة، وأدَ حكمُ البعث السلطوي، إلى جانب الانقلابات العسكرية، تلك المحاولات وقيّدها. قد تكون هذه التسمية محطة أولية للمّ شمل المشهد الثقافي في الداخل والخارج، وإعادة تموضعه وسط سياقه المتوسطي، كإطار جامع شامل يملك كل المؤهلات لاحتضان التعددية الثقافية والفنية السورية.
حواريًا، قد يكون فتح أبواب الحوار الإقليمي المدني أهم ما في هذه التسمية. ونقصد هنا إيجاد مساحة، أو خلق “مختبر” عام، نفهم فيه ونطوّر على مدار عام كامل كل السرديات والأفكار والأنماط التي نشأت في الداخل والشتات السوري ضمن سياق ومساندة أورومتوسطية.
لقد شكّل الشتات السوري شبكات هائلة، مدنية وثقافية، كما ترتبط بالبيئة الأورومتوسطية الدولية منظمات عديدة مهمّة، تملك الأهلية لجلب الفعاليات الدولية إلى دمشق، وهنا نتحدث –على سبيل الذكر لا الحصر– عن “الاتحاد من أجل المتوسط” بكل منصاته ومشاريعه الإقليمية، وعن “مؤسسة آنا ليند” وشبكاتها الواسعة للمجتمع المدني الأورومتوسطي، و”المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط” بصفته شاغلًا للأمانة العامة لشبكة “يوروميسكو” لمعاهد الأبحاث والسياسات الأورومتوسطية، وغيرها كثير.
استثماريًا، على الرغم من أن التسمية معنوية ولا تتضمن رسميًا أية منح مادية، فإنها رسمية وتحمل الشرعية لتنظيم وحشد التمويلات الدولية، الحكومية والتنموية والخاصة. ونظرًا لكون الاقتصاد السوري أمام فرصة نمو هائلة نتيجة الاحتياجات القطاعية الشديدة، ستُسهم هذه التسمية في تنظيم تلك التمويلات والمشاريع على المدى القريب، إذ توفر لها إطارًا خدميًا وتمويليًا.
لاحتضان الزوار الخارجيين، ستحتاج دمشق إلى خطة تنمية حضرية أولية ضمن مسار إعادة الإعمار، عبر تعزيز المساحات العامة، ودعم القطاعات السياحية، السكنية والغذائية، ووسائل النقل، والمنشآت الصحية، وغيرها. ولا يُطلب من العاصمة تحوّل جذري خلال سنة ونصف، لكن الدعوة ستسرّع العمل وتحفّز القطاع الخاص، خاصة أن الفعاليات لن تكون مركّزة في يوم أو أسبوع واحد، بل على مدار العام، ما يجعل التخطيط لهذه الفعاليات ممكنًا ومستدامًا.
دمشق وقرطبة ونزار قباني
قبل تعيينه سفيرًا لسوريا في إسبانيا في الستينيات، زار نزار قباني قرطبة الأندلسية وكتب قصيدته: “في أزقة قرطبة الضيقة، مددتُ يدي إلى جيبي أكثر من مرةٍ لأُخرج مفتاح بيتنا في دمشق”.
ترتبط دمشق وقرطبة بتاريخ طويل بدأ مع الرومان، وبلغ أوجه حين دخل الأمويون قرطبة لتكون عاصمتهم بعد دمشق، حاملين معهم عمارة وأشجارًا وثمارًا وعلومًا وأشعارًا.
حديثًا، تمّت توأمة دمشق وقرطبة رسميًا عام 2002 عقب مشاركة الرئيس (المخلوع) بشار الأسد في افتتاح موقع آثار المدينة الزهراء بجانب قرطبة بدعوة من الملك الأسباني آنذاك خوان كارلوس وتمثيل ولي العهد (الملك الحالي) فيليبي السادس.
الزهراء، التي أسّسها عبد الرحمن الثالث لتكون مركز الحكم الجديد، والمعروفة في الأشعار العربية، كانت مفقودة لقرون طويلة، واكتُشف موقعها في بدايات القرن العشرين، ولا يزال مدخل الموقع التراثي يحتضن تذكارًا يوثق زيارة الرئاسة.
وفيما يخص ملف التسمية، أعلنت بلدية قرطبة عن تجهيز ملفها للتقدّم لتسمية “العاصمة المتوسطية للثقافة والحوار” عن الضفة الشمالية للمتوسط لعام 2027، وتستطيع دمشق التنسيق مع قرينتها لتقديم ملف مشترك. ستحتاج المدينتان لعقد اتصالات سريعة تنسيقية، بدعم من الخارجية السورية والإسبانية.
دمج الطلب له فائدة في دعم الملف بشكل قوية كما له أهداف استراتيجية، حيث سيحفز ملف سوريا السياسي في المنطقة، ويخلق علاقة مقربة مع الحكومة الإسبانية، التي لم تتوانَ في الترحيب بالتغيرات الأخيرة.
ما هي متطلبات ملف الترشيح؟
في عام 2022، أطلق “الاتحاد من أجل المتوسط”، بالتعاون مع “مؤسسة آنا ليند” و”الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية”، مبادرة “العواصم المتوسطية للثقافة والحوار”، بناءً على توصية وزراء الثقافة الأورومتوسطيين، وبدعم من المنتدى الإقليمي لوزراء خارجية الاتحاد في العام ذاته. يُجرى كل عام اختيار مدينة من الضفة الشمالية وأخرى من الضفة الجنوبية. وقد شملت الدورة الأولى هذا العام كلًا من تيرانا الألبانية والإسكندرية المصرية، وتليها في العام المقبل ماتيرا الإيطالية وتطوان المغربية، المدينتان الغنيّتان بمواقع التراث الإنساني.
تدور حاليًا عملية الترشح لعام 2027، مما يمنح دمشق وقتًا كافيًا لإعداد ملفها الثقافي، إذا توفّرت الإرادة السياسية. ويتطلب الترشح إعداد ملف واقعي، يعكس الإمكانيات الثقافية الكامنة رغم التحديات. ولا يُشترط تقديم برنامج ثقافي مكتمل، بل رؤية طموحة قابلة للتنفيذ، لعام متوسطّي الطابع، تُصمَّم بمشاركة فاعلة من المؤسسات الثقافية المحلية، والمدارس، والجامعات، والمجتمع المدني.
الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشح هو31 تموز 2025.
أما التحدي السياسي الأبرز، فيكمن في استعادة عضوية سوريا في “الاتحاد من أجل المتوسط” التي قد تُشترط لتقديم ملف التسمية، وهو هدف قد يتحقق عبر جهد دبلوماسي فعّال، لا سيما بالتنسيق مع إسبانيا التي ستدعم ملف ترشيح قرطبة، وتتمتع بتأثير ملحوظ في السياق الأورومتوسطي.
ليس ترشيح دمشق مجرد لفتة رمزية، بل فرصة لإعادة تقديم سوريا إلى العالم من بوابة الثقافة والحوار، بعد سنوات من الصراع والانكفاء.
تلفزيون سوريا
————————
من يحرر يحكم.. مقولة ننفيها ونطبقها/ عدنان علي
2025.04.23
في قاعة أحد الفنادق بدمشق، دار نقاش أمامي بين صحفي وضابط رفيع منشق عن جيش نظام الأسد. لم يكن نقاشاً رسمياً، بل ودياً بين صديقين، حيث اشتكى الضابط من أن وزارة الدفاع في دمشق لم تلتفت إليه، ولا إلى كثير من الضباط المنشقين، بينما جرى تولية غير الضباط، وغير المؤهلين، وفق ما يرى، مناصب رفيعة.
وحين قال له صديقه، إن من العدل أن يكون قائد فرقة على الأقل، وأنه يستحق أيضاً منزلاً، كما منح الآخرون منازل كانت لضباط نظام الأسد، زاد من انفعاله وحنقه على ما يجري، متسائلاً ماذا عساه أن يفعل، وأن كرامته لا تسمح له باستجداء حقه من أحد.
حينها، بادرت إلى محاولة التخفيف عليه، وقلت له إن حالنا نحن في الإعلام، ليس أفضل منكم أنتم العسكر، وحال أيضا كثير من الفئات الأخرى. وهناك كثير من أمثالي، ممن عملوا في الإعلام لعقود، وانشقوا عن إعلام النظام، وحين انتصرت الثورة، لم يكترث بهم أحد، وجرى تولية معظم مناصب الإعلام لأشخاص آخرين من الناشطين الوافدين من الشمال، أو ممن لهم صلة معهم، ممن كانت لهم تجارب إعلامية شجاعة ومقدرة على صعيد التغطيات الميدانية، لكن خبراتهم لا تؤهلهم لقيادة مؤسسات إعلامية كبيرة، لم يتسن لهم العمل في مثلها من قبل.
ولا يعقل أن يتولى إدارة التلفزيون شخص لم يعمل سابقا في أي تلفزيون، وأن يتولى إدارة صحيفة شخص، لم يدخل في حياته إلى مبنى صحيفة.
وطبعا، يمكن أن تقول أشياء مشابهة عن العديد من القطاعات الأخرى، خصوصا الإدارة العامة، لكن في تلك المواقع يمكن للشخص أن “يتدبر أمره”، بما أن العمل، يعتمد على “الشطارة”، وليس التخصص. بمعنى آخر، إدارة بقالية أو مطعم، يمكن للوهلة الأولى أن يتولاها أي شخص، لكن سيظهر الفارق في وقت لاحق، بين الشخص المؤهل لهذه المسألة، والشخص المقتحم عليها، من خلال الخسائر التي ستلحق بالبقالية أو المطعم، نتيجة سوء الإدارة، وقلة الدراية بأسرار المهنة.
بطبيعة الحال، يمكن لشاب طموح ومتواضع، بمعنى أنه حريص على اكتساب المعرفة من أي مصدر، أن ينجح في إدارة مؤسسة، حتى دون خبرة سابقة، لكن ستكون هناك ولا شك أخطاء كثيرة في البداية، لأن هذا الشخص، والفريق الذي معه، يتعلمون بالتجريب، ولا يستفيدون من تراكم خبرات سابقة.
لكن ما هو مبرر كل ذلك؟ لماذا لا يتم إشراك الجيل الأقدم في إدارة هذه المرحلة، وتطعيم التجربة بشكل تدريجي بالجيل الجديد؟
في الواقع، لا إجابة مقنعة على مثل هذا السؤال، سوى أنه حب الاستحواذ والاستئثار بالسلطة والقرار، مع قلة خبرة في الإدارة العامة، لدرجة يشعر معها أصحاب القرار أنهم يستطيعون إدارة أي شيء، ولا حاجة لهم للاستعانة بأحد، حتى ممن هم في صفهم السياسي، لكنهم كانوا يعارضون النظام من مواقع أخرى، غير تلك التي حضرت من الشمال.
هنا نعود للمقولة الشهيرة “من يحرر يقرر” والتي ينفيها المسؤولون في دمشق، خاصة الرئيس أحمد الشرع، لكن الجميع يلمس للأسف أثرها على أرض الواقع!
والحقيقة، لا يمكن أن نعتبر أن هذا هو بالكامل نهج مقرر ومعتمد، ولعل كثير من الممارسات على أرض الواقع مردها فقط، ضعف الخبرة في الإدارة العامة، وليس رغبة مبيتة وصارمة بالاستئثار بكل السلطات.
إلى الآن، لا يوجد نهج أو خطة معتمدة لاستقطاب الخبرات في المجالات المختلفة. ما زال الأمر، كما كان في عهد النظام السابق يعتمد على التزكيات والمعارف. وفي مثل هذا الوضع، لا يتقحم غالباً غير المتطفلين والمتملقين، أما أصحاب الخبرة الحقيقيون، فإن ما لديهم من أنفة واعتداد بالنفس، يجعلهم يبتعدون، وينتظرون أن يتم التواصل معهم من المعنيين، وهذا نادرا ما يحصل.
قديماً قيل، “طالب الولاية لا يولى”، لكنه اليوم يولى، بل لا يولى غيره مع الأسف، في ظل عدم وجود آليات علمية موثوقة للبحث عن أصحاب الكفاءات في المجالات كافة، الإدارية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والسياسية.
لا شك أن البناء السليم للمجتمع السوري المنهك بعقود من الحرب والفساد وسوء الإدارة، يتطلب وجود عقل إداري سليم، على رأس كل وزارة ومؤسسة، يتولى استقطاب الكفاءات عبر برامج علمية وعملية، وليس مجرد شعارات يتم ترديدها، والقدرة على تفعيل ما هو موجود منها، واستخراج أفضل من عندها. أما إذا هيمنت عقلية إقصائية، لا تعترف بخبرات الآخرين، أو تتعالى عليها، فسوف تكون النتيجة مزيد من الاحتقان المجتمعي، ومزيد من السلبية، حتى من جانب النخب التي رأت في انتصار الثورة، وزوال حكم آل الأسد، نصراً شخصيا لها، ليس من منطلق “إذا لم أتول منصب، سأكف عن تأييد الحكم الحالي”، بل لأن بديل حكم الأسد، خيب أملهم بأن يكون لهم قيمة واعتبار في مجتمعهم، بعد عقود من التهميش. وهذا التقدير قد يكون مجرد تقدير معنوي، وليس تولي مناصب بالضرورة، علماً أن ذلك من حقهم، إن كانت لديهم الكفاءة المطلوبة.
تلفزيون سوريا
————————————-
استثناءات من حظر السفر.. إجراءات تقنية مؤقتة أم اعتراف دولي بالشرع؟/ أغيد حجازي
23 أبريل 2025
كشفت وثائق صادرة عن مجلس الأمن الدولي عن منح الرئيس السوري أحمد الشرع استثناءات متعددة من حظر السفر المفروض عليه منذ 24 تموز/يوليو 2013، بسبب إدراج اسمه في قائمة تنظيم القاعدة. وسمحت له هذه الاستثناءات الممنوحة في عام 2025 المشاركة في فعاليات دبلوماسية تحت عنوان “تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا”. لماذا تم منح هذه الاستثناءات؟ وما هي آليتها؟ وما الرسائل السياسية الكامنة وراءها؟
آلية منح الاستثناءات: بين القواعد والمرونة
وفقًا لقرارات مجلس الأمن، يمكن للدول أو الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات التقدم بطلب استثناء من حظر السفر لأسباب محددة، مثل المشاركة في مفاوضات سلام، أو تلبية احتياجات إنسانية وتشمل المتطلبات:
• تحديد الغرض الدقيق من السفر (مثل حضور منتدى دبلوماسي أو اجتماعات طارئة).
• تقديم جدول زمني مفصل يشمل نقاط المغادرة والعودة ووسائل النقل.
• إرفاق وثائق داعمة كدعوات رسمية من الحكومات المضيفة.
ووافقت اللجنة المختصة، التابعة لمجلس الأمن، على طلبات زيارات الشرع التي تهدف إلى “تلبية احتياجات إنسانية”، وهو ما يتوافق مع البنود التي تسمح بالسفر لدعم عملية السلام أو المبادرات الإنسانية.
جدول الزيارات.. أين ومتى؟
تشير الوثائق إلى أن الشرع حصل على تصاريح سفر لكل من السعودية (2-4 شباط/فبراير 2025): إعفاء من حظر السفر فيما يتعلق بالزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية. وتركيا (4-5 شباط/فبراير 2025): إعفاء من حظر السفر تلبية لاحتياجات تحقيق الاستقرار والاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا.
كما أن الشرع زار مجموعة من الدول الأخرى: الأردن (26 شباط/فبراير 2025)، الإمارات (13 نيسان/أبريل 2025)، قطر (15 نيسان/أبريل 2025)، إلا أن الوثيقة لم تتضمن تصاريح استثنائية لزيارة هذه الدول كونها قد صدرت في تاريخ سبق هذه الزيارات.
إعفاءات تفتح باب الأسئلة
يرى السياسي والدبلوماسي السوري السابق، بشار علي الحاج علي، في حديثه لـ”الترا سوريا”، أن منح مجلس الأمن إعفاءات متكررة من حظر السفر لشخص مدرج على لائحة العقوبات لا يعد، بالمعنى القانوني، إلغاءً لتدابير الجزاء أو رفعًا للعقوبات، بل يصنف كإجراء تقني استثنائي، تجيزه آلية العقوبات نفسها وفقًا للفقرة 1 من القرار 1267، والتي تسمح بالإعفاء من الحظر لأسباب إنسانية أو سياسية محددة.
لكن التكرار في منح الإعفاءات، لا سيما إذا ارتبط بمشاركات دبلوماسية رفيعة ومتعددة الأطراف، يعبر عن تحول نوعي في نظرة المجتمع الدولي لهذا الشخص، ولو ضمن حدود ضيقة، وهو بمثابة اعتراف وظيفي، وليس اعترافًا سياسيًا كاملًا، يسمح له بأداء دور معين، لكن ذلك لا يؤهله تلقائيًا لنيل شرعية دولية شاملة، حسب تعبير الحاج علي.
ويشير المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني، إلى أن الإعفاءات المتكررة من حظر السفر للرئيس أحمد الشرع، رغم كونه مدرجًا على لوائح العقوبات، تعني أن هناك تحولًا في كيفية تعاطي المجتمع الدولي معه، مضيفًا أن مجلس الأمن يملك آلية قانونية تتيح منح إعفاءات من حظر السفر “لأغراض إنسانية، أو إذا اعتبر أن السفر يصب في مصلحة عملية السلام أو الاستقرار”.
ويؤكد الكيلاني أن تكرار هذه الإعفاءات يشير إلى أن الرئيس الشرع ينظر إليه كطرف يمكن أن يسهم في الانتقال السياسي، لا كعدو أو معرقل. ومن ثم، يتم التعامل معه كـ”فاعل سياسي ضروري” ضمن ترتيبات ما بعد سقوط النظام البائد.
بين الالتزام القانوني والحاجة الواقعية
يقول الحاج علي إن الإعفاءات، في جوهرها، أدوات عمل مرنة ضمن منظومة العقوبات، وتستخدم عادة عندما تقتضي ضرورات السياسة الدولية التفاعل مع أطراف مقيدة، خاصةً في حالات الانتقال السياسي أو إدارة ما بعد النزاع. في حالة الشرع، يبدو أن هذه الإعفاءات ليست مجرد رد فعل عابر، بل تأتي في إطار تفاعل محسوب مع السلطة الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد، مع استمرار الحذر القانوني والسياسي، وهي تمثل توازنًا بين الالتزام بالشكل القانوني للعقوبات والحاجة الواقعية للتعامل مع الفاعلين الجدد. ما يعني أن المجتمع الدولي لم يمنحه بعد “شيكًا على بياض”، لكن منحه منفذًا مؤسسيًا (قانونيًا) للظهور.
يفسر الكيلاني، في حديثه لـ “ألترا سوريا”، هذه الإعفاءات وفقًا لما توضحه آلية مجلس الأمن (UN Travel Exemptions Criteria)، فهي تمنح عادةً لأسباب مؤقتة مرتبطة بضرورات سياسية أو إنسانية. لكن هنا، وبالنظر إلى تواتر الإعفاءات واتساع نطاقها (زيارة دول إقليمية رئيسية مثل تركيا والسعودية وقطر والإمارات)، فهذا يشير إلى بداية تفاعل دولي منظم مع السلطات الجديدة، وليس مجرد استجابة لحاجة عابرة.
يتابع الكيلاني: “الإعفاءات بدأت كاستثناء سياسي طارئ لكنها تطورت لتعبر عن اعتراف عملي، وإن كان حذرًا، بشرعية سياسية جديدة يتم التفاوض عليها”.
هذه المرونة في تطبيق العقوبات ليست سابقة فريدة، بل هي استنساخ لسيناريوهات سبقتها في السودان وأفغانستان، حيث منحت قيادات فرصًا محدودة للحوار، كجسر نحو تفاهمات قد تعيد رسم خريطة القوى. لكن السؤال الأكبر: هل تشكل هذه الإعفاءات بداية لـ”انفراجة” سورية تقودها شروط المجتمع الدولي، أم هي مجرد فاصل يعيد إنتاج الأزمات بأدوات مختلفة؟
المرونة في تطبيق العقوبات
بحسب الحاج علي، يعكس حضور الشرع في محافل دبلوماسية، وخصوصًا في دول كانت تقاطع دمشق حتى وقت قريب، قبولًا إقليميًا – دوليًا مشروطًا به كلاعب في المرحلة الانتقالية، لكن ضمن أطر محسوبة بدقة.
ويلفت إلى أن هذا لا يعني أن الرجل بات ممثلًا شرعيًا أو أنه تجاوز القيود السياسية، بل أن ما يحصل هو نوع من التدرج في إعادة التأهيل السياسي، تخضع فيه تحركاته لمراقبة دولية لصيقة، ويشبه ذلك ما شهدناه في حالات سابقة، مثل التعامل مع بعض قيادات “طالبان” أو “المجلس العسكري السوداني”، حيث منحت إعفاءات مقيدة لممثلين يخضعون للعقوبات بغرض تسهيل التفاوض دون منح شرعية مطلقة.
ويوضح الحاج علي أن هذه المشاركة تمثل اعترافًا وظيفيًا محدودًا، لا اعترافًا سياسيًا شاملًا، القبول بالحوار معه، لا تبني لخطابه أو سياساته، وهو ما يبرز أن المجتمع الدولي لا يزال يبقي ملف الشرعية مفتوحًا على احتمالات متعددة، مشروطة بسلوك الداخل السوري، لا بمجرد حضوره الخارجي.
يؤكد الكيلاني أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في مؤتمرات دولية وإقليمية، وبوجود إعفاءات رسمية من مجلس الأمن، تعكس عدة نقاط:
1- موقعه السياسي: رئيس لمرحلة الانتقال السياسي في سوريا.
2- حدود القبول الدولي: هناك قبول حذر به كلاعب رئيسي، كدعم لمرحلة التعافي في سوريا ودعم الاستقرار. مع ذلك، هذا القبول مرتبط بشروط المرحلة الانتقالية، وليس دعمًا مفتوحًا له شخصيًا أو لفريقه.
3- مشاركته في فعاليات بدول محورية (تركيا، السعودية، قطر، الإمارات) توحي بأن هناك شبكة إقليمية تسانده، مما يقوي موقعه في المفاوضات الدولية.
من جهته يرى القاضي المستشار، خالد شهاب الدين، أن الإعفاءات الممنوحة من المجتمع الدولي للرئيس الشرع ليست مطلقة، بل هي مؤقته ومعلقة على اختبار جوهري: مدى التزام الحكومة السورية بالتحول نحو حكم مدني ديمقراطي يتوافق مع محيطه الإقليمي، ويبتعد عن صفة “الدولة الشاذة”. ويضيف أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أكدت أن استمرار هذه الإعفاءات – أو إلغاءها – رهن بسلوك النظام، سواء عبر بناء مؤسسات سوريا على أسس القانون، أو بالعكس، عبر تعميق طريقة الحكم التي كانت في إدلب ومناطق الصراع.
ويشير شهاب الدين إلى أن الاستثناءات التي منحت مهمه ولولاها كيف كان الشرع سيتحرك؟ والأسماء المدرجة على قوائم العقوبات الدولية اليوم مضطرة لتغيير نهجها، والاستثناءات رغم أهميتها لتمكين الرئيس الشرع من لعب أدوار دبلوماسية محدودة، تعتبر بمثابة ورقة ضغط لإجباره على الاختيار بين مسارين:
– مسار التعافي: عبر تحسين الأداء السياسي والأمني، ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات وحذف الأسماء من قوائم الإرهاب.
– مسار التصعيد: عبر استمرار الخروقات، ما سيدفع المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات وعزل سوريا مجددًا.
يختم القاضي بالقول: “الكرة الآن في ملعب السلطة السورية. فالتاريخ لا يكرر نفسه، لكنه يعطي فرصًا محدودة لمن يصرون على تعلم دروسه”.
تظل استثناءات حظر السفر الممنوحة للرئيس السوري أحمد الشرع نقطة مهمة في قراءة المشهد السياسي السوري والدولي. ويبقى السؤال قائمًا: هل تشكل هذه الإعفاءات نافذة لتحول تدريجي في الموقف الدولي، أم أنها مجرد أداة مؤقتة لإدارة الأزمات؟ والإجابة ربما تكمن في التفاصيل غير المعلنة للمفاوضات خلف الكواليس.
الترا سوريا
—————————-
سوريا ضمن “آلية خماسية”.. اندماج في الإقليم أم دخول في محور جديد؟/ محمد كساح
22 أبريل 2025
في الوقت الذي تقول فيه تركيا إنها تسعى، من خلال الإعلان عن تشكيل آلية إقليمية خماسية، إلى توجيه رسالة دعم للسلطة السورية الجديدة، يرى مراقبون أن الخطوة الجديدة تخفي غايات أعمق لأنقرة الراغبة في الحصول على دور كبير في الإقليم، مقابل انحسار غير مؤكد لتل أبيب، الراغبة في لعب الدور الإقليمي الذي يسد فراغ غياب كل من طهران وموسكو عن المشهد.
وضمن هذا السياق، يلفت خبراء سياسيون إلى أن التحوّط حول مخرجات وانعكاسات هذه الآلية واجب على السوريين، انطلاقًا من أن إدخال البلاد في سياقات إقليمية مشروطة قد يُفضي إلى استدامة التداخل الأمني لا إلى تحييده، محذرين من أن عدم توفر رؤية سورية وطنية قادرة على قيادة هذا الانخراط من موقع فاعل، لا من موقع ردّ الفعل أو التلقي، يعني تحويل سوريا إلى ساحة تماس دائم بين قوى متعددة المصالح.
وكان نائب وزير الخارجية التركية، نوح يلماز، قد أعلن عن تشكيل آلية إقليمية خماسية، بهدف التصدي “للدور الإسرائيلي المزعزع للاستقرار الاستراتيجي في المنطقة”، وذلك عقب لقاء جمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري أحمد الشرع، على هامش “منتدى أنطاليا” الدبلوماسي.
وقال يلماز إن الآلية الخماسية تضم تركيا وسوريا والعراق والأردن ولبنان، موضحًا أنها ليست نظامًا إقليميًا جديدًا، إنما خطوة عملية لتوفير أدوات دعم وتنسيق، ومساعدة سوريا في بناء نوع من القدرات. ولفت إلى أن مركز التنسيق الخاص بها سيكون داخل الأراضي السورية، وأن جميع الطلبات المتعلقة بمهامها ستصدر من الجانب السوري.
إدماج سوريا في الإقليم
الآلية الخماسية المعلن عنها تبدو، من حيث الشكل، خطوة باتجاه بناء إطار تنسيقي إقليمي مشترك يهدف إلى التعامل مع التحديات الأمنية العابرة للحدود، لكنها في جوهرها تعكس محاولة لتثبيت نوع من الإدارة الإقليمية للأمن في المناطق السورية في ظل غياب سلطة مركزية قوية، وفقًا لقراءة أدلى بها الكاتب والباحث الأكاديمي مالك حافظ لـ”الترا سوريا”.
ويوضح حافظ أن التأكيد على أن مركز التنسيق سيكون داخل الأراضي السورية، وبأن الطلبات ستُوجه من الجانب السوري، لا يعني بالضرورة أن هناك سيادة فعلية، بل يشير إلى محاولة لترسيخ ترتيبات مؤقتة تُدار عبر توافقات إقليمية لا من داخل بنية دولة وطنية مستقلة، وهذا يعيد التأكيد على هشاشة المشهد السوري، الذي بات يتشكل ضمن أطر توافقية خارجية أكثر منه مسارًا سياديًا وطنيًا متكامل الأركان.
ويتابع قائلًا إن الإعلان يحمل نبرة سياسية تجاه إسرائيل، لكنه لا يرتقي إلى مستوى إعلان صريح عن بناء جبهة مواجهة أو تحالف أمني دفاعي مشترك، مؤكدًا أن أقصى ما يمكن قراءته في هذا السياق هو رسالة رمزية تعبّر عن انزعاج من الانكشاف الإقليمي أمام السياسات الإسرائيلية، دون أن تكون مقرونة بآليات ردع فعلية.
ويلفت حافظ إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الآلية تؤسس لحماية سياسية أو أمنية مؤسسية للسلطة الانتقالية في سوريا، انطلاقًا من أن هذه السلطة لا تزال محدودة الحضور والشرعية داخليًا وخارجيًا، وتفتقر إلى التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بلعب أدوار في منظومات أمن إقليمي. وبالتالي، فإن تضمينها في هذه الآلية يبدو أقرب إلى خطوة رمزية تهدف إلى إظهار انخراطها في البيئة الإقليمية، دون أن يكون ذلك دليلًا على تحصينها الفعلي، أو تبنيها الكامل من قبل جميع الأطراف.
ويلاحظ حافظ أن هناك تصوّرًا يتشكل تدريجيًا مفاده أن سوريا في مرحلتها الانتقالية يعاد إدماجها في منظومات إقليمية ذات طابع أمني ــ سياسي، تُسهم في تثبيت الاستقرار وفق رؤية بعض الفاعلين الإقليميين، وفي مقدمتهم تركيا. مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تفضي، في حال لم تضبط بوضوح، إلى تحول سوريا إلى ساحة تماس دائم بين قوى متعددة المصالح، ما يعرقل مسار استعادة سيادتها الوطنية الشاملة.
أهداف غير معلنة
يرى الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي أن الهدف الأساسي من “الآلية الخماسية” ليس ما هو معلن في التصريحات الرسمية، وإنما الغاية منها إعادة دمج الحكومة السورية في الإقليم، لافتًا خلال حديث لـ”الترا سوريا” إلى أن ما يدلل على هذه الغاية هو أن الدول الداخلة ضمن الآلية الخماسية هي الدول المحيطة والمحاذية لسوريا.
ويضيف أن تركيا تريد أن تلعب دور الوسيط الإقليمي بهدف الحصول على دور سياسي واقتصادي مقبل في سوريا، وفي الإقليم بشكل كامل. ويلفت إلى أن الآلية بقدر ما تشكل إعلانًا واضحًا عن رفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، فهي عبارة عن دعم وحماية للسلطات السورية الجديدة من قبل تركيا، لكن دون أن تصل الأمور إلى الصدام مع إسرائيل.
يرى متابعون أن من شأن هذه الآلية أن تظهر سوريا كجزء من المحور التركي، وبالتالي تعزيز تحول سوريا إلى ورقة ضغط بيد الأتراك. ويتفق علاوي مع هذه الفرضية بأبعادها الظاهرية، موضحًا أن سوريا ستبدو شكليًا جزءًا من المحور التركي، لكن ذلك لن يكون الخيار الوحيد، حيث أرسلت السلطة السورية رسائل عديدة بأنها لا تنتمي لأي محور، وليس أدل على ذلك من زياراتها إلى مصر والإمارات والسعودية.
الترا سوريا
———————————
=======================
عن الأحداث التي جرت في الساحل السوري أسبابها، تداعياتها ومقالات وتحليلات تناولت الحدث تحديث 23 نيسان 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
الأحداث التي جرت في الساحل السوري
———————————
في المسألتين العلوية والسنّية/ حسين عبد العزيز
22 ابريل 2025
بلور دعم العلويين للنظام وعياً سُنّياً في جزءٍ منه صحيح من حيث مطابقته الواقع، وفي جزئه الآخر مضاعفاً تجاه العلويين، فلو اتصف النظام بالحكم الرشيد، ولو قدّمت الطائفة العلوية مشروعا سياسيا حداثيا، لما نشأت الريبة تجاه العلويين، ولما تضاعفت إشكاليّتهم في الوعي الجمعي السُني الثائر.
لا يمكن فصل أسئلة الديمقراطية والمواطنة والعدالة الانتقالية وطبيعة النظام السياسي عن المسألة الطائفية في المجتمعات العمودية (حيث تتداخل البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية معاً)، فالطائفية هنا جزءٌ أصيلٌ من هذه الأسئلة، بمعنى أن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب طرح الإشكال الطائفي بكل شفافية، خصوصاً وضع الطائفة العلوية في الحالة السورية.
ولكي يكون طرح المسألة العلوية عقلانياً وموضوعياً، يجب الإجابة عن سؤالين رئيسيين: هل كان النظام السوري في عهد الأسدين طائفياً أم سلطوياً؟ وهل كان العلويون، كجماعة لها هُوية فرعية مثل جميع الهُويات الأخرى، طائفيين مناهضين في تفكيرهم وسلوكهم للأكثرية السُنية؟… على الرغم من أن الإجابة عن السؤالين صعبة، إلا أن محاولة تقديم إجابة عنهما ربما تساهم في فهم الإشكال وتجاوزه على المستوى الوطني في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها سورية.
نظام الأسديْن
النظام الطائفي هو الذي يُخصص موارد الدولة لأجل هدف محدّد، رفع مستوى الطائفة التي ينتمي إليها على حساب باقي الطوائف. إذا ما بدأنا بالصعيد الديني لوجدنا، من جهة، أن أول ما قام به حافظ الأسد القضاء بالقوة على أي محاولة علوية لبناء مرجعية دينية، حتى لا تتحوّل الطائفة إلى كتلة ذات وزن اجتماعي ـ هُوياتي، يمكن لها أن تلعب دوراً خارج دائرة منظومة النظام الحاكم. ولوجدنا، من جهة ثانية، أن الأسد لم يسمح بشرعنة أي دين على مستوى الدولة، سوى المذهب السُني، المسموح له فقط بالتعبير عن ذاته مؤسّسياً وتعليمياً باعتباره يُشكل هوية سورية، إلى جانب حرّية العبادة للمسيحيين، أما الطوائف الاخرى، فلم يكن يُسمح لهم بإظهار الطقوس الدينية علناً.
على مستوى الاقتصاد، لم يكن نظام الأسد في توزيعه للأعطيات طائفياً، فقد كان يغضُ الطرف عن كل بارونات النظام، بمعزلٍ عن انتمائهم الديني والطائفي، فالأعطيات وعمليات التجارة الشرعية وغير الشرعية كانت توزّع تبعاً لمقتضيات السلطة فقط (الولاء).
وعلى الصعيد الاجتماعي، حرص الأسد الأب على بقاء العلويين فقراء في قراهم، حتى يكونوا خزّاناً داعماً للنظام، لأن التاريخ ونتائج التحليل السوسيولوجي يؤكّدان أن الوفرة الاقتصادية ستؤدّي بالضرورة، إلى التفكير البراغماتي المتعارض مع بنى التفكير العضوية.
وعلى المستوى السياسي، لم يعمل النظام على تحويل العلويين إلى طائفة سياسية من شأنها أن تتحوّل إلى كتلة تاريخية سياسية قادرة على فرض نفسها، فهذا كان خطّاً أحمر، فما هم إلا أدواتٌ في خدمة النظام، ومن يحاول الاعتراض يُقتل على الفور.
ويؤكّد احتياج نظام الأسد الطائفة العلوية أنه، مثل أي نظام سلطوي مهما بلغت قسوته، يحتاج إلى تحالفاتٍ اجتماعيةً متعدّدة الهُويات، على الرغم من أن البنية القسرية له قائمة على الجيش والأجهزة الأمنية، وإذا كانت الأخيرتان تؤكّدان تمركز السلطة عموديا، فإنهما غير كافيتين لتوسيعها أفقياً. ولهذا احتاج الأسد أربعة أركان لضمان توسيع سلطته واستمراريتها:
أولاً، ضرورة تماهي الطائفة العلوية مع النظام، بإحياء مظلومية تاريخية وتضخيمها أيديولوجياً، وعبر توسيع توظيف أفراد الطائفة في جميع مؤسّسات الدولة، رابطاً بذلك حاجتهم الاقتصادية من جهة وبذاكرتهم التاريخية من جهة أخرى من أجل ربط مصيرهم بمصير النظام. ثانياً، التحالف مع البرجوازية السنية الفاعلة، وهو تحالفٌ سرعان ما تحوّل إلى تزاوج بين السلطة والمال. ثالثاً، إدخال أفراد الريف في مؤسسات الدولة كافة، خصوصاً المؤسستين العسكرية والأمنية (أغلبيتهم سُنة)، من أجل القضاء على الهيمنة السياسية والاقتصادية التاريخية لدمشق وحلب. رابعاً، اعتماد أيديولوجيا قومية عابرة للطوائف، تضع القضية الفلسطينية في القلب منها.
وفق هذه المعطيات التاريخية، لم يكن النظام طائفياً، بل كان سلطوياً رثّاً بامتياز، استغل الذاكرة التاريخية العلوية الممتلئة بالمظلومية التاريخية لتدعيم سلطته، ولم يكن اختيار حافظ الأسد العلويين للمناصب الحساسة نابعاً من أيديولوجية طائفية علوية، بقدر ما كان نتاجاً لما تتطلّبه السلطة، إنها العصبية بالمعنى الخلدوني.
الطائفة العلوية
بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالطائفة العلوية، فهو السؤال الأصعب والأكثر تعقيداً: أن تُرحب الطائفة العلوية بوصول شخصٍ منها إلى رئاسة الجمهورية (حافظ الأسد) وتدعمه، فهذا طبيعيٌّ ومفهومٌ ومبرّر، كما هو حال أي طائفة وإثنية غيرها.
لكن ما حصل منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعيْد أحداث حماة (1982)، أن النظام أمنن الطائفة العلوية وعسكرها، وشيئاً فشيئاً، أخذت الطائفة بعموميتها تجد نفسها جزءاً أصيلاً من النظام: ظهر ذلك عبر تسهيل انخراطهم جماعياً في العمل في مؤسّسات الدولة، خصوصاً الأمنية والعسكرية، على حساب غالبية أبناء الطائفة السنّية الذين وجدوا صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة حكومية.
وظهر ذلك عبر استهجان أي عملية نقد فردية للنظام من خارج الطائفة، والأمثلة لا تُعد ولا تُحصر، إلى درجة أن أحداً لا يجرؤ على نقد الأسد أمام أي علوي، مع حالات استثنائية نادرة. المقصود من هذا أن الطائفة العلوية وجدت في النظام عصباً لها، بقدر ما وجد الأخير فيها عصباً له. ومن هنا، كانت للطائفة مصلحة قوية ببقاء نظام الأسد الأب والابن، كما كانت لنظام الأسديْن مصلحة قوية ببقاء العلويين جزءاً أصيلاً من ترتيباتهما الداخلية.
ولا يعني ذلك كله أن ثمة تماهياً كلياً بين الطائفة والنظام، فهذا غير ممكن عملياً، فكثير من العلويين، بمن فيهم المؤيدون للنظام، غير راضين عن سلوكه الداخلي، لكن ثمة فارقاً هاماً بين عدم الرضا هذا والخروج عليه: لقد كان النقد أو عدم الرضا ينبع من داخل الوحدة، لا من خارجها، ولهذا استمرّ العلويون في دعم بقاء النظام دائماً في كل الأوقات، بما فيها العصيبة منها.
وأي محاولة من بعض الأشخاص للحديث عن وقوف سوريين علويين مع المعارضة ضد نظام الأسد هو قول حق يُراد به باطل، فالاستثناء لا يُلغي القاعدة، ولا تنفع هنا محاولة الفصل بن النظام والطائفة العلوية، ولا تنفع أيضاً محاولات بعضهم اعتبار العلويين مجرّد أدوات داخل مشروع الدولة الأمنية، ففي ذلك تقليل من قيمة العلويين بتحويلهم إلى مجرد قطيع لا فكر ولا إرادة لهم.
لم تكن العلاقة المتداخلة بين الطائفة والنظام قائمةً على أيديولوجيا دينية، أي بنظام المعتقدات الديني، ولا بمصالح اقتصادية واسعة، بل من أجل هُوية علوية، وهذا ما يدفعنا إلى النظر إلى الكينونة السياسية في فهم سلوك الطائفة.
يتعلق الأمر بالمستوى السياسي عند المفترق التاريخي الذي انتقلت فيه الطائفة العلوية من طائفةٍ اجتماعيةٍ منغلقةٍ خلال قرون عديدة إلى طائفةٍ اجتماعيةٍ منفتحةٍ منذ مرحلة الاستعمار الفرنسي، ثم إلى طائفة سياسية وسمت تاريخ سورية المعاصر بشخص حافظ الأسد، وانعكس ذلك مباشرةً في وعيها الجمعي، ونشأت أنا جمعية متضخّمة، تقطع مع التاريخ الغابر، وترفض استذكاره، وترفض أيضاً فكرة تغيير الواقع الحالي، مع ما يستجلبه ذلك من مآسٍ في مخيّلة الوعي الجمعي للطائفة، قد تنالها من الحكّام الجدد إذا ما سقط النظام. وهذا ما يُفسّر نجاح النظام بتحويل الطائفة العلوية بعد الثورة إلى خزّانٍ بشريٍّ رئيسٍ في القتال، ذلك أن مخاطرة الفرد بتعريض حياته للموت يتطلّب أكثر من مجرّد ترويع أمني أو منافع اقتصادية أو سياسية.
وقد بيّنت تجارب التاريخ العديدة، خصوصاً في الحروب، أن الحوافز المؤثّرة في سلوك البشر، ليست اقتصادية، فهي الأقل ثباتاً وديمومة، وإنما الحوافز الأكثر خصوصيةً للنفس البشرية، مثل العاطفة الدينية أو العصبية الهُوياتية. وبهذا المعنى، يشكّل هذا النوع من العواطف، إلى جانب الأيديولوجيا العُصبوية، الآليات الرئيسة التي تصوغ اللحمة بين الطائفة والحرب في أوقاتٍ معينة. وهذا ما يفسّر، أيضاً، كيف أن الطائفة العلوية، في عموميّتها، لم تنظر إلى مطالب الثورة عام 2011 أنها مطالب حداثيةٌ ترمي إلى إسقاط نظام دكتاتوري بوليسي لصّ، من أجل بناء دولة الحرية والديمقراطية والمواطنة، بقدر ما نظرت إلى هذه المطالب من منظارٍ طائفيٍّ، هو عودة الهيمنة السُنّية.
أهي علوية سياسية؟
بيّنت الأحداث منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي حجم الانطواء العلوي على الذات، فلم نشهد ظهور قيادة جماعية موحّدة ممثلةً للعلويين قادرة أن تعبّر عنهم وتعبر بهم إلى أمان سياسي من النخبة الحاكمة، حتى بعد التطمينات التي قدّمها الشرع مباشرة أو من خلال رجاله إلى العلويين في الأسابيع الأولى التي أعقبت سقوط النظام.
يؤكد ذلك زيف مقولة “العلوية السياسية” التي ردّدها كثيرون، وأولهم صادق جلال العظم، حين اعتبر هيمنة المكون العلوي على مفاصل الدولة الحساسة كافيةً لنعت هذا المصطلح باعتباره حقيقة قائمة، وبهذا تصبح “العلوية السياسية” مرتبطةً بالشخوص لا بالبرامج السياسية وطبيعة النظام السياسي.
ويُفهم من كلام العظم أن “العلوية السياسية” ظاهرة استثنائية، ولا تكمن استثنائيّتها في طبيعة العلاقات المتداولة في المنظومة السلطوية، ولا في دورها السياسي كمنظومة إنتاج معرفية ـ سياسية، وإنما تكمن استثنائيّتها في أن العلويين كأقلية يستأثرون بحكم بلدٍ يطغى عليه السُنة.
والحقيقة أن هيمنة علويين على المفاصل الخطيرة في النظام لا يؤدّي، بالضرورة، إلى وجود “علوية سياسية” على غرار “المارونية السياسية” في لبنان، ويا ليت “علوية سياسية” نشأت في سورية، فلو حصل ذلك لاضطرّت إلى ترك مسافة مع النظام من أجل تقديم نموذج سياسي يسمح لها بالاستمرار كجماعةً سياسية، مع ما يتطلبه ذلك بالضرورة من تقديم نموذج سياسي حداثي.
وسواء كان النظام هو الذي منع نشوء “علوية سياسية” أم أن هذا الأمر كان خارج المُفكر فيه لدى العلويين، فإن وقوف الطائفة بالعموم إلى جانب النظام، لا سيما بعد اندلاع الثورة، يؤكّد انعدام وجود هذه الظاهرة السياسية، فأقصى ما كانت تأمله الطائفة بقاء نظام الأسد مع تحسين سلوكه الداخلي سياسياً، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، أي بقاء مكامن القوة الاجتماعية كوعي هُوياتي، وهذا منوطٌ ببقاء النظام.
من الجانب السُني، بلور دعم العلويين للنظام وعياً سُنّياً في جزءٍ منه صحيح من حيث مطابقته الواقع، وفي جزئه الآخر مضاعفاً تجاه العلويين، فلو اتصف النظام بالحكم الرشيد، ولو قدّمت الطائفة العلوية مشروعا سياسيا حداثيا، لما نشأت الريبة تجاه العلويين، ولما تضاعفت إشكاليّتهم في الوعي الجمعي السُني الثائر. هنا، يبدو من المهم طرح سؤال حقيقة العلويين، بخلاف ما ذهب إليه البعض حين اعتبر سؤالاً غير مهمّ.
لكي يخرج هذا السؤال من العباءة الطائفية إلى العباءة الوطنية، وجب أن يشمل كل مكوّنات المجتمع، لأن معرفة حقيقة هُوية المكونات السورية تسمح لنا بإصدار حكم سياسي يبدو ملحّاً اليوم، ولنا في المثال الدرزي ما يؤكد ذلك، فذهاب وفد درزي سوري إلى إسرائيل يفرض، بالضرورة، طرح سؤال حقيقة الدروز، أو على الأقل حقيقة بعض منهم، إنه سؤال الهُوية الضروري في هذا المفترق التاريخي الذي تمرّ به سورية. وينطبق الأمر نفسه على الأكثرية السُنية، المطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بكشف حقيقتها، أهي مشروع وطني جامع، أم هيمنةٌ سُنّيةٌ بلباسٍ سياسيٍّ متنوّعٍ في الظاهر، كما كان حكم الأسد: دكتاتورية فجّة تحت غطاء تعدّدية حزبية.
ما العمل؟
وفقا لما تقدّم، يمكن أن أحاجج بأن المكوّن العلوي اليوم هو أكثر المكوّنات استعداداً للانخراط في مشروع وطني جامع، لا بسبب حالة الخوف الجماعية لديهم حالياً، ولا بسبب تعميةٍ أو تقيةٍ سياسيةٍ لتمرير الوقت فحسب، بل والأهم لأنهم خبروا حقيقة النظام خلال السنوات الخمس الماضية تحديدا، وشاهدوا كيف انتهى حكم الأسد اللص.
لقد أدركوا الآن أن آل الأسد كانوا يستغلون الطائفة لحماية عروشهم ليس إلا، وأن نظام الأسد رمى الطائفة على مذبح الثورة.
وبهذا، يمكن القول إن الحالة العلوية اليوم تعبّر عن حالة سياسية خام، فإما أن يُدفع بهم إلى الانطواء على أنفسهم وإعادة تكرار الماضي، أو أن يُدفعوا إلى الانخراط في الدولة الجديدة.
لا توجد لدينا معطياتٌ واضحةٌ يمكن من خلالها إطلاق أحكام سياسية محدّدة تجاه الحكم الجديد في سورية، فلا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان يُمارسون تقية سياسية، ظاهرها الانفتاح على كل المكوّنات الاجتماعية وإشراكها في الحكم الجديد، وباطنها الاستئثار السُني بالحكم، عبر إعادة إنتاج عصبية سنّية على غرار ما فعل الأسد بإنتاج عصبية علوية.
في جوهر المشروع السياسي الحديث الذي يُنتجه الشرع، شكلاً من أشكال التنافر الأنطولوجي، فما يحدثُ عملية إقصاء واضحة لجميع مكوّنات المجتمع السوري على المستوى السياسي، في وقتٍ يعدُ فيه الشرع السوريين بمرحلة سياسية تقطع مع استبداد النظام السياسي. والسلوك السياسي للحكم الجديد ذي اللون والمسار الأوحد يفتح الباب أمام أطراف داخلية كثيرة لتلمّس مساراتها السياسية والهُوياتية بعيداً عن الدولة. في هذه المفاصل التاريخية الفارقة في الدول والمجتمعات، يكون للفاعل السياسي الدور الرئيس، إما بأخذ البلد إلى برّ الأمان أو دفعه إلى التهلكة.
وفي الحالة السورية المعقدة، لن يكون أمام الحكّام الجدد سوى سبيلين: الأول، اعتماد النهج الإيراني القائم على هيمنة التيار الديني المتشدّد، سواء في مرحلة الخميني، عندما قرّرت النخبة الحاكمة المتشدّدة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، ليس بإقصاء التيارات اليسارية فحسب، بل إقصاء الشخوص الإصلاحية داخل التيار الإسلامي.
السبيل الثاني، الارتقاء إلى مستوى استلهام نهج نيلسون مانديلا إذا استطاع الشرع وأركان حكمه إلى ذلك سبيلاً، باعتماد أسلوب مانديلا السياسي، حين ارتقى بنفسه فوق الخلافات، بوصفه رئيساً لكل الشعب، وحين مدّ يده إلى قادة ثوريين آخرين يتبعون أيديولوجياتٍ ومصالح إقليمية مختلفة جدّاً، في وقت كان فيه قادراً على الاستفراد بالحكم، غير أن بصيرته كرجل دولة فرضت عليه اختيار التشارك السياسي لا الإقصاء.
وإذا ما افترضنا أسوأ السيناريوهات، وهو الخيار الأول، فالحلُّ، بالنسبة لباقي مكوّنات الشعب السوري، لا يكون باعتماد السلاح كما حصل في الساحل من فلول نظام الأسد، ولا بالارتماء في الحضن الإسرائيلي كما فعل بعض الدروز، وإنما بإعادة تجميع سياسية لكل القوى من أجل ممارسة الضغط السياسي، مدعومين بشخصياتٍ كثيرة من السُنة ليست راضية على شكل الحكم الجديد وجوهره.
العربي الجديد
——————————
عندما تنفجر ألغام التاريخ في الساحل السوري/ منير شحّود
21 ابريل 2025
طرحت الأحداث الأليمة التي اشتعلت ليلة 6 مارس/ آذار 2025 في الساحل السوري مزيداً من الأسئلة المتعلقة بالاجتماع السوري عامة، وفي المنطقة الساحلية على وجه الخصوص، بما في ذلك تحوّل المزاج الشعبي السوري العلوي نحو التفكير في طلب حماية أجنبية، وذلك بسبب ما اقترفته في مدنيين عزّل بدموية فصائل غير منضبطة أو تابعة للفصائل المنضوية تحت مسمى وزارة الدفاع في الدولة السورية الجديدة، والتي اتخذت من المدن الساحلية منطلقًا لها للتنكيل بالقرى العلوية المحيطة، بعد هجوم مجموعة من فلول النظام على مواقع عسكرية تابعة للسلطة وحواجز الأمن العام.
تهدف هذه السطور إلى تقصي العلاقة التاريخية بين سنة المدن الساحلية والعلويين منذ تشكيل دولة العلويين في عام 1920 وحتى التحاقها التام بالدولة السورية أواخر عام 1945، ومحاولة الربط بين مجريات الأحداث الحالية والالتفاف على ما نصت عليه معاهدة 1936 من استقلال مالي وإداري لمحافظة اللاذقية.
دولة العلويين
بعد حوالي عامين من نزول قواتها في اللاذقية، أنشأت سلطة الانتداب الفرنسية دولة للعلويين في 2 سبتمبر/ أيلول 1920، ثم أنشأت ثلاث دول سورية أخرى (دمشق وحلب وجبل الدروز). كان إنشاء دولة خاصة بالعلويين نقلة نوعية في تاريخهم السياسي أسهمت في تعزيز الهوية العلوية وتطويرها، ولم يكن سقفهم آنذاك يتجاوز التبعية المباشرة لرؤساء عشائرهم.
أُطلقت على هذه الدولة تسميات عدة بين عامي 1920 و1936، وكان إطلاق تسمية حكومة اللاذقية في 1930 للتخفيف من تسمية دولة يشكل فيها العلويون أغلبية الثلثين فقط. كان للمنطقة الغربية من سورية ما يميّزها بالفعل، ومنه ارتباطها التاريخي بساحل سورية الطبيعية الجنوبي (لبنان وفلسطين)، بحكم التقسيمات الإدارية في العهدين المملوكي والعثماني، نظراً إلى تبعية سنجق اللاذقية لولاية طرابلس أو بيروت أو عكا، وليس للداخل السوري الذي كان يتبع لولايتي دمشق وحلب.
أثار وضع الساحل السوري تحت الحماية الفرنسية المباشرة، المتمثلة بسلطة المفوض الفرنسي في بيروت، مخاوف سنة المدن الساحلية، فكانوا الداعم الأساسي لثورة الشيخ صالح العلي الذي كان قد آثر الاستجابة لدعوة الشريف حسين بن علي للهجوم على القوات التركية المنسحبة من سورية أواخر عام 1918، ومن ثم دعم ابنه الأمير فيصل مقاومة القوات الفرنسية من أجل أن يُتوج ملكاً على سورية. بذلك كانت ثورة العلي من مصلحته الشخصية ومصلحة فيصل ومؤيديه من سنّة المدن الساحلية، لكنها أوحت بوجود تيار علوي عريض مؤيد للوحدة، الأمر الذي لم يكن واقعيّاً آنذاك. ففي بداية 1920، كان التيار الوحدوي بقيادة صالح العلي ضعيفاً بين العلويين، ولو أنه كان مدعوماً من زعامة عشيرة المتاورة في مصياف وقليلين من الزعامات العلوية الأخرى، بينما كان التيار الاستقلالي العلوي هو الأقوى، وقد فضّل أنصاره العمل في إطار دولة العلويين أو الانضمام إلى دولة لبنان الكبير، التي كانت قد تأسست في أغسطس/ آب 1920. لكن، وعلى أرضٍ سياسية متحرّكة باستمرار، فاز التيار العلوي الوحدوي في نهاية فترة الانتداب، بشرط تحقيق الاستقلالين، الإداري والمالي، لمحافظة اللاذقية حسب ما جاء في معاهدة 1936، إذ اشترط مرسوم ضم محافظة اللاذقية إلى سورية أن يكون لها ميزانية خاصة ونظام إداري خاص و16 نائباً في البرلمان.
وفي أثناء محادثات 1936، قامت في محافظة اللاذقية مظاهرات رافضة للوحدة ومظاهرات أخرى مؤيدة لها، كما أُرسلت البرقيات والعرائض إلى عصبة الأمم المتحدة والعواصم الفاعلة، معبرة عن قلق الأقليات بشأن توحيد سورية، وذلك بينما كانت المباحثات تجري بين الفرنسيين الذين أرادوا أن يكون للعلويين وضع خاص مع الإبقاء على حامية عسكرية فرنسية في المنطقة، ووفد الكتلة الوطنية التي تريد توحيد منطقة الساحل السوري مع سورية الأم بصورة تامة، فكان الاتحاد مع سورية بشرط الاستقلال المالي والإداري حلًّا وسطًا .
وخطت الأخيرة خطوتين متكاملتين للتقريب بين العلويين والكتلة الوطنية، فعيّنت حليفها العلوي عزيز هواش محافظًا لدمشق (1936)، بينما أعطت زيارة “وفد بلاد العلويين” إلى دمشق دفعاً جديداً لأنصار الوحدة، وذلك بما حظي به الوفد من تكريم واهتمام إعلامي، فعقد، فور عودته إلى الساحل، اجتماعين سياسيين في كل من القرداحة وطرطوس للتشجيع على الوحدة مع سورية، ولكن بشرط الاستقلالين، المالي والإداري، المذكورين آنفاً.
وكان الخلاف حول القوانين العلمانية التي وردت في المرسوم الانتدابي رقم 60 (1936) قد احتدم بين العلمانيين والدينيين في ظل سلطة الانتداب، إلى أن حسمت حكومة لطفي الحفار، التي خلفت حكومة جميل مردم بك في فبراير/ شباط 1939، المسألة، وشكلت لجنة لدراسة نظام الطوائف، فأقرّت اللجنة العودة إلى الشريعة الإسلامية. وافق المفوض السامي على إلغاء العمل بالمرسوم 60 وحصر تطبيقه بغير المسلمين فقط، 30 مارس/ آذار 1939. وبما أن مفتي القدس الحاج أمين الحسيني، كان قد أصدر فتوى في يوليو/ تموز 1936 اعتبر فيها العلويين مسلمين، ربما كان ذلك مثل رشوة لقبولهم الانضمام إلى سورية، فلم يعودوا يشكلون طائفة مستقلة وانضووا في إطار الشريعة الإسلامية طائفة مسلمة.
الكتلة الوطنية تناور
اشتكى العلويون بين عامي 1937 و1939 بأن بلادهم لم تحصل على الحكم الذاتي كما نصت عليه المعاهدة الفرنسية -السورية، وأن الحكم المركزي فُرض عليهم وتجاهلت السلطات حقوقهم. وفشل محافظ اللاذقية إحسان الجابري في تهدئة الوضع ولم تتعدَّ سلطاته مدن الساحل، فأُقيل عام 1939. وفي 12 يناير/ كانون الثاني 1942 ضمتْ محافظة جبل العلويين رسميّاً إلى سورية، ونشر النظام الأساسي لها بالقرار رقم 23/ ف. ل، والذي أُدرج ملحقاً لمعاهدة 1936، وجاء فيه أن هذه المحافظة تتمتع باستقلالين، مالي وإداري. ومن الواضح أن الكتلة الوطنية، ومعها معظم زعامات سنة الساحل، كانت تناور للتخلص من شرط الاستقلال المالي والإداري (النسبي) لمنطقة العلويين وتنتظر الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك، مخافة أن تنفصل هذه المنطقة عن سورية الأم، ولا سيما أن غالبية سكانها من العلويين. وبقي الأمر معلّقاً بين مطالب الكتلة الوطنية التي تعتبر وحدة الأجزاء السورية “حقّاً جوهريّاً”، ومطلب الاستقلال الإداري والمالي لمنطقة الساحل السوري. ونظراً إلى أن العلويين كانوا منقسمين حول مسألة الوحدة، وأن فرنسا هي من فاوضت عنهم، عملت الكتلة الوطنية على النفاذ من هذه الثغرة والمضي في الإجراءات التي أفضت في النهاية إلى تمرير الوحدة التامة من دون مناقشة كافية في المجلس النيابي، واعتبار موضوع الحقوق الإدارية في الساحل السوري مجرد “وضع شاذ”!. ففي غمرة “الابتهاج الوطني” بقرب جلاء القوات الفرنسية عن سورية، أعلن نائب جبلة، جمال علي أديب، في جلسة البرلمان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 1945، تنازل مقاطعته عن الاستقلالين، المالي والإداري، وحذا باقي نواب محافظة اللاذقية حذوه، بما في ذلك النواب العلويون. وبذلك انتصرت إرادة الكتلة الوطنية بصورة شبه قهرية، وإذا أضفنا إلى ذلك الممارسات القمعية لحكومة جميل مردم بك بحقّ العلويين بعد الجلاء، فربما ساهم ذلك، إضافة إلى عوامل أخرى، في تقويض حكم الكتلة الوطنية لاحقاً، من خلال سلسلة الانقلابات العسكرية التي كان للضباط العلويين دور مهم فيها.
اللحظة التي لم يتم اقتناصها
كان سكان محافظة اللاذقية في 1936 منقسمين بين من يريد الاتحاد مع سورية بصورة تامة أو شبه تامة ومن يريد الانفصال عنها بصورة تامّة أو شبه تامّة أيضاً، ولكن فكرة الحل اللامركزي، من خلال الاستقلال المالي والإداري، وحَّدت المتنازعين؛ أي العلويين والسنة والمسيحيين والإسماعيليين. بالفعل، كان خيار الحفاظ على خصوصية منطقة الساحل مناسباً لجميع سكانه، ويمكن أن يساهم في وحدتهم على أساس المصلحة، لكنه لم يكن ليتوافق مع سياسة الكتلة الوطنية التي حكمت سورية بُعيد الاستقلال، خاصة أن سورية الداخل كانت تحتاج إلى منفذ بحري. وفي هذه النقطة بالذات، تكمن استماتتها لضم الساحل بصورة تامة أواخر عام 1945. كما كان يمكن لما جاء في معاهدة 1936 أن يبدد النمطية التاريخية للعلاقة بين السنة والعلويين والمسيحيين في الساحل السوري. إنها اللحظة التاريخية التي لم تُلتَقط بسبب فيضان المشاعر العروبية التي ستتحول إلى “عماء سياسي” في العقود التالية.
من جهة ثانية، يمكن تفسير قبول النواب العلويين لإلحاق محافظة اللاذقية بلا شروط بالدولة السورية بعدة عوامل، أهمها شعورهم بضعف الدور الفرنسي وهيمنة الإنكليزي عليه في نهاية الحرب، علاوة على ما ارتكبته سلطة الانتداب في 29 مايو/ أيار 1945 بقصفها مدينة دمشق وتدمير البرلمان، بعد رفض الدولتين السورية واللبنانية توقيع اتفاقيات خاصة مع فرنسا، فقد أثار العدوان الفرنسي تضامناً وطنيّاً شمل مناطق العلويين أيضاً.
لاحقاً، سبّبت مرحلة الاستبداد الأسدي زيادة الشرخ الاجتماعي المكبوت بين العلويين والسنة، بسبب زيادة المساحة التي تحرك فيها العلويون في الفضاء الساحلي وامتيازات المرتبطين منهم بالسلطة الحاكمة، الأمر الذي انعكس سريعاً بعد سقوط النظام أواخر عام 2024، فسعى معظم سكان المدن من السنة إلى الاستقواء بالسلطة الجديدة، وشكل بعضهم نوعاً من الحاضنة الاجتماعية للفصائل المتطرّفة التي ارتكبت المجازر بحق المدنيين العلويين، في حين وقف آخرون إلى جانب جيرانهم العلويين، وتعرضوا للقتل أحياناً ثمناً لموقفهم الإنساني هذا.
أخيراً
كان شرط الاستقلال المالي والإداري لمحافظة اللاذقية هو الأمر الذي وافقت عليه جميع الأطراف في المحافظة، كما ورد أعلاه، وكانت لحظة مهمّة يمكن أن تحقق استقراراً مهمّاً مبنيّاً على مصلحة جميع سكان المحافظة. وربما لم يكن الاستبداد الأسدي ليجد له موطئ قدمٍ في سورية، بما تضمنه شرط الاستقلال المالي والإداري من خدمة للمجنّدين ضمن محافظتهم.
لم يعد بالإمكان الخروج من الحالة الراهنة باستخدام وصفات سياسية تقليدية، انطلاقاً من فكرة استمرار الحكم المركزي المعادل للاستبداد، إذ يحتاج الأمر إلى نوع من الحوكمة اللامركزية على كامل مساحة الدولة السورية، خاصة في المناطق الثلاث (الجزيرة والساحل وجبل الدروز)، التي عارض معظم سكانها الانضمام التام إلى الدولة المركزية، وظهر ذلك جليّاً بعد سقوط النظام الأسدي. يتيح النظام اللامركزي، بدرجاته المختلفة، حرية أكبر في إدارة المكونات السورية شؤونها الخاصة والحفاظ على تقاليدها وخصوصياتها الثقافية والدينية، في إطار المواطنة المتساوية للدولة المدنية الديمقراطية المتعثرة.
العربي الجديد
———————————
=======================
واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 23 نيسان 2025
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع
———————————
6 أسباب وراء نفور العشائر العربية في سوريا من “قسد”/ اسماعيل درويش
أبرزها تجنيد الشباب والأطفال وتغيير المناهج الدراسية والاختلاف حول عوائد النفط والإقصاء والتحالف مع نظام الأسد
الأربعاء 23 أبريل 2025
هناك أسباب عدة جعلت من العشائر العربية تنظر إلى “قسد” على أنها عدو، أو في الأقل تنظيم غير مرغوب فيه، وهذه الأسباب تتمثل في فرض التجنيد وتجنيد الفتيات والقصّر، وتغيير المناهج الدراسية بما يخالف خصوصية القبائل والاستئثار بعوائد النفط، إضافة إلى إقصاء “قسد” للعنصر العربي في إدارة المناطق العربية، فضلاً عن التحالف المريب مع النظام السابق، وآخرها الاختلاف الأيديولوجي بين “قسد” والعشائر العربية.
في السادس من يوليو (تموز) عام 2024، كانت قوات النظام السوري السابق تسيطر على غالبية أحياء مدينة حلب، باستثناء مناطق محددة في شمالها حيث سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، تحديداً في حي الشهباء، حاجز لـ”قسد” يوقف الطفلة سيدرا عبدالحنان حسين التي تنحدر في الأصل من مدينة عفرين، واقتاد العناصر الطفلة التي هي من مواليد 2010 إلى أحد مراكز ما يسمى “واجب الدفاع الذاتي”، وهو يوازي مراكز الخدمة العسكرية التي كانت تنتشر في مناطق سيطرة النظام، وكلها تستخدم لسوق الشباب السوريين إلى التجنيد الإجباري بهدف القتال ضد أطراف الصراع الأخرى، إلا أن إحدى أهم “الكوارث” التي كانت تنفذها “قسد” هي تجنيد الفتيات والقاصرين، وفق بيانات أممية نسردها في هذا التقرير.
سيدرا حسين تنضم إلى قرابة 341 طفلاً اقتادتهم “قسد” إلى التجنيد الإجباري، غالبيتهم ينحدرون من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، حيث الثقل العسكري الحقيقي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.
وتجنيد الأطفال والتجنيد الإجباري للشباب، يضاف إليه وضع مناهج دراسية تخالف العادات والتقاليد الخاصة بأهالي شمال شرقي سوريا، وكذلك التعاون مع النظام السابق والاستئثار بعائدات النفط الضخمة ومنع العنصر العربي من الاشتراك في صنع القرارات المصيرية، وغيرها من الأسباب، دفعت أبناء القبائل والعشائر العربية في مناطق سيطرة “قسد” إلى اعتبار الأخيرة عدواً غير مقبول في مناطقهم، مطالبين باقتصار سيطرتها على المناطق ذات الغالبية الكردية، من دون أن يكون لها أي وجود في المناطق العربية.
التجنيد وتجنيد الفتيات والقصّر
في الخامس من يونيو (حزيران) عام 2023، أصدر مجلس الأمن الدولي تقريراً حول “الأطفال والنزاع المسلح عن عام 2022″، وورد في التقرير أن سوريا كانت أسوأ بلدان العالم على الأطفال في 2022، حيث سجل التقرير “تجنيد واستخدام 7622 طفلاً بينهم 1696 طفلاً في سوريا وحدها، وتصـدرت “قـوات سـوريا الديمقراطية” ووحـدات حماية الشـعب ووحدات الحماية النسـوية وقـوات الأمن الداخلي الخاضعة لسـلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سـوريا، قائمة الأطراف الأكثر استخداماً للأطفال في التجنيد الإجباري”.
وقبل ثمانية أعوام من هذا التقرير، تحديداً في الـ15 من يوليو 2015، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً حمل عنوان “قوات كردية تنتهك حظر تجنيد الأطفال”، أوضح أن “قسد”، “وقعت في يونيو 2014 صك التزام مع منظمة نداء جنيف غير الحكومية، تعهدت فيه بتسريح جميع المقاتلين دون عمر الـ 18 سنة في غضون شهر، وبعد شهر من توقيع الاتفاق، قامت وحدات حماية الشعب الكردية بتسريح 149 طفلاً، وعلى رغم الوعد الذي قدمته وتحقيق بعض التقدم، وثقت ’هيومن رايتس ووتش‘ على امتداد سنة من تاريخ التوقيع، التحاق أطفال دون عمر الـ18 سنة للقتال في صفوف الوحدات، ويبدو أن بعض الأطفال قتلوا خلال معارك عام 2015، وهناك 10 من بين 59 طفلاً التحقوا بوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة عام 2014 هم دون عمر 15 سنة”.
وبين هذين التقريرين والفارق الزمني الممتد إلى ثمانية أعوام، صدرت عشرات التقارير الأممية والحقوقية والإعلامية التي تسلط الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة “قسد”، وبعد ضغوط غربية ودولية قررت “قسد” عقد اتفاق جديد مع الأمم المتحدة حول هذه القضية، لكن هذه المرة وقع الاتفاق رأس الهرم في قيادة القوات مظلوم عبدي، ففي الأول من يوليو 2019، وصل مظلوم عبدي على رأس وفد من “قسد” إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث وُقع اتفاق ينص على “منع تجنيد الأطفال دون عمر الـ18 سنة”.
ويشمل الاتفاق الذي أطلق عليه اسم “خطة عمل”، تسريح الفتيات والفتيان المجندين حتى هذا التاريخ وفصلهم عن القوات، إضافة إلى منع وإنهاء تجنيد الأطفال، ووقع على الاتفاق من جانب الأمم المتحدة حينها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، وبتوقيع هذا الاتفاق اعتبرت “قسد” أولى الجهات المسلحة التي توقع هذا النوع من الاتفاقات، كما اعتبر التوقيع اعترافاً من “قسد” بوجود عمليات تجنيد في صفوفها، خلافاً للقانون الدولي الذي يمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية دون سن الـ 18، وفق المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق بـ”اتفاقية حقوق الطفل”، بينما يعتبر تجيند الأطفال دون عمر الـ 15 سنة جريمة حرب.
وليست هناك أرقام رسمية دقيقة لعدد عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” وباقي الجماعات الكردية المسلحة التي تنضوي تحتها، إلا أن مراقبين يرون أن العدد الكامل لا يقل عن 20 ألفاً ولا يزيد على 30 ألفاً، فيما يرفض سكان مناطق شمال شرقي سوريا ذات الغالبية العربية الالتحاق بالتجنيد الإجباري في صفوف “قسد” الذي يمثل أحد أسباب التوتر بين الطرفين.
وعلى رغم أن العشائر والقبائل العربية اختلفت في ما بينها من ناحية الولاء لأطراف النزاع السوري المختلفة، فإن غالبيتها رفضت دعم مشروع “قسد”، ومع ذلك هناك أجنحة عربية عدة داعمة لمشروع “قسد” والإدارة الذاتية، إلا أن الطاغي هو مطالبة القوات باحترام خصوصية العشائر والمناطق العربية وعدم سوق أبنائها للتجنيد الإجباري، فضلاً عن عدم تجنيد القاصرين والأطفال، لكن أياً من ذلك لم يحصل، مما أسفر عن تكرار التظاهرات والتصعيد، ووصل إلى حد شن هجمات عسكرية ضد حواجزها، وتكرار طرد عناصر “قسد” من بعض القرى والبلدات، خصوصاً في محافظة دير الزور، حيث نسبة سكانها الأصليين من الأكراد شبه معدومة، وعلى رغم ذلك تسيطر “قسد” على كامل ريفها الشمالي وأجزاء واسعة من ريفيها الغربي والشرقي.
تغيير المناهج الدراسية “أيدولوجيا أوجلانية”
قبيل أسابيع من مطلع العام الدراسي 2020-2021، عقدت “الإدارة الذاتية” اجتماعاً مع المعلمين في مناطق سيطرتها بدير الزور والحسكة والرقة، الاجتماع استثنى معلمي مناطق سيطرة “قسد” بريف حلب، وخلاله أبلغت “الإدارة الذاتية” المعلمين بأنها ستطرح منهاجاً جديداً بدلاً من المنهاج المعمول به في مدارس المنطقة الشرقية.
وفي كتاب التاريخ الصفحة رقم 82، الدرس الرابع بعنوان “الأخلاق عند عبدالله أوجلان”، يتطرق الدرس إلى “الأخلاق التي يتمتع بها زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان”، وينتقد ما سماها “أخلاق المجتمعات المنحطة”، وفي كتاب الجغرافيا الصفحة 125 توجد خريطة لـ “دولة كردستان” وتضم أجزاء واسعة من سوريا والعراق وتركيا وإيران، ويتحدث الدرس عن “الطبيعة الجغرافية لدولة كردستان” الممتدة وفق الخريطة على كامل الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا لتصل إلى البحر المتوسط، وتقتطع أجزاء كبيرة من جنوب وشرق تركيا، وصولاً إلى كامل الحدود التركية- الأرمينية، ثم تتصل بجورجيا، وشرقاً تقتطع جزءاً كبيراً من الحدود العراقية الإيرانية.
وإعلان “قسد” تغيير المناهج الدراسية أثار موجة غضب واسعة النطاق في المنطقة الشرقية، حتى قرر وجهاء المنطقة صياغة بيان باللغة العربية والإنجليزية، وإرساله إلى الولايات المتحدة الأميركية، الداعم الرئيس لـ”قسد”، لمنعها من تغيير المناهج الدراسية، وبحسب البيان الصادر في يوليو عام 2020، فإن “المنهاج الذي تفرضه ’قسد‘ على المناطق التي تخضع لسيطرتها في المنطقة الشرقية منافٍ لموروثات ومبادئ وأخلاق أهالي المنطقة بصورة كاملة، وقد ألغى المنهاج تاريخ المنطقة العربي والإسلامي، وأزال جميع الشخصيات التاريخية واستبدلها بشخصيات تعتبرها ’قسد‘ نضالية مثل عبدالله أوجلان، إضافة إلى فتيات غير معروفات صدرتهن القوات على أنهن رمز للعطاء والتضحية، مما استفز أهالي المنطقة من دون استثناء”.
ووفق بيان أهالي المنطقة الشرقية، فإن “المنطقة حافظت على تركيبتها السكانية منذ ستة قرون والقائمة على العشيرة كمكون اجتماعي وقيمي لها وعلى التعايش السلمي بين أبنائها، وعلى رغم ما تعرضت له المنطقة من احتلالات ومحاولات للتغيير فإنها حافظت على تماسكها وحاربت كل أنواع محاولات إخضاعها، مما قطع الطريق على أية محاولة لتغيير موروثها ومعتقداتها الدينية والاجتماعية والأخلاقية، أما التعديلات التي أجرتها الإدارة الذاتية على محتوى بعض الكتب فهي محاولة منها لطمس التاريخ العربي للمنطقة عبر إلغاء مادة التربية الإسلامية وإضافة كتب خاصة بالإلحاد والديانة الزردشتية واليزيدية، إضافة إلى تغيير أسماء بعض المناطق، وإذا مُرر هذا المنهاج فنحن أمام مشكلة كبيرة لأنهم مسيطرون عسكرياً على المنطقة، خصوصاً أن بعض المعلمين رفضوا تدريس هذا المنهاج التعليمي لأنه يتنافى مع قيم وأخلاق وتاريخ وحضارة المنطقة الشرقية، فهم سيكونون في خطر أمام التهديدات التي ربما تطاولهم من ’قسد‘، كما نخشى إجبار أولياء الأمور على إرسال أولادهم للتعلم ضمن المنهاج الجديد”.
وإضافة إلى رفض سكان المنطقة مناهج “قسد”، فإن ذلك من جانب آخر يخالف أيضاً “اتفاقية جنيف” لعام 1949 التي تنص على أن “الدول التي تدخل إلى منطقة ما مسؤولة عن حماية أملاكها ومعتقدات أهلها والموروث الخاص بها”، وانتهاك هذه الاتفاقية كان سبباً آخر يُضاف إلى الأسباب التي شكلت حالاً من العداء بين أبناء العشائر العربية و”قسد”.
الذهب الأسود… ناتج بلا عوائد
وتعد قضية النفط من الأسباب الرئيسة للتوتر بين “قسد” والعشائر العربية، خصوصاً في مناطق مثل دير الزور والحسكة التي تحوي أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، حيث تسيطر “قسد” على أكبر أربعة حقول في البلاد (حقل العمر، وهو أكبر حقل على الإطلاق، وحقول التنك والرميلان والشدادي)، وهذه الحقول وغيرها مؤمنة من قبل قوات “قسد”، ويمنع المدنيون أو العشائر من الاقتراب أو التدخل في عمليات الإنتاج أو التسويق، ويُكرر قسم من النفط محلياً ويباع في السوق السوداء أو يُهرب إلى مناطق سيطرة النظام السابق أو شمال العراق، والأسعار عادة تكون أرخص من السوق العالمية، لكن الأرباح تذهب بصورة رئيسة إلى “الإدارة الذاتية”، وكانت شركة “القاطرجي” الوسيط بين النظام السابق و”قسد” في عمليات بيع النفط.
ولا توجد بيانات واضحة عن كمية الإنتاج أو كيف تُوزع العائدات، فترى العشائر أن النفط من أرضها ولا يعود لها شيء من مردوده، في المقابل تعاني المناطق الغنية بالنفط، خصوصاً دير الزور والحسكة فقراً شديداً وضعفاً في الخدمات وانعداماً للبنية التحتية على رغم الثروة النفطية، مما عزز شعور الأهالي بأن “قسد” تنهب الثروات من دون مقابل، كما يوجه الأهالي اتهامات لمسؤولين في “الإدارة الذاتية” أو متنفذين في “قسد” بوجود شبكات فساد وسرقة للنفط بالتعاون مع سماسرة محليين أو إقليميين.
في المحصلة، تعتبر العشائر العربية أن “قسد” تستغل ثروات النفط الموجودة في أراضيها، من دون أن توزع العائدات بعدل أو تطور المناطق التي تسيطر عليها، وتقصي أبناء تلك المناطق من إدارة مواردهم، مما زاد أيضاً من حال الاحتقان في الشارع وظهر جلياً خلال الاحتفالات التي خرجت ليلة توقيع الاتفاق بين “قسد” والحكومة السورية، والقاضي بعودة المنطقة لسيطرة الدولة السورية.
إقصاء “قسد” العنصر العربي من الإدارة
وفي الهرم القيادي لتنظيم “قسد”، تعتمد على قادة أكراد في الصفوف الأولى، فيما يكون للعنصر العربي دور محدود للغاية ضمن المناطق ذات الغالبية العربية، فشكلت هذه القضية محوراً حساساً ورئيساً في الخلاف بين العشائر العربية و”قسد”، إذ تعتبر العشائر العربية أن القوات الكردية “تقصيها” من إدارة مناطقها، ففي بداية تشكيل “قسد” كانت وحدات حماية الشعب الكردية “YPG” العمود الفقري لها، لكن بعد التوسع في المناطق العربية، خصوصاً في الرقة ودير الزور، صار مطلوباً من “قسد” إشراك العرب، فجرى ضم مقاتلين وإداريين عرب، لكن القيادة الفعلية والمفاصل المهمة ظلت بيد العناصر الكردية، خصوصاً المرتبطين بحزب العمال الكردستاني، وبقي الوجود العربي يقتصر على بعض المجالس المدنية والهيئات، لكن القرارات المهمة والمصيرية تحسم من قبل كوادر كردية، بخاصة في الملفات الأمنية والعسكرية والمالية، وإضافة إلى ذلك جرى تهميش كثير من الكفاءات العربية ممن يتمتعون بالخبرات، أو لديهم وزن عشائري، وفي بعض الحالات تُختار شخصيات عربية غير مؤثرة للعمل في “الإدارة الذاتية”.
وتهميش العنصر العربي وفرض نمط إدارة جديد على مناطق عشائرية لها طابع قبلي تقليدي، سبّبا صداماً ثقافياً وحساسية في المنطقة، وعلى رغم أن الهيكلة العسكرية لـ”قسد” تضم عناصر عرب، فإن المناصب القيادية (قادة القطاعات والاستخبارات والتنسيق الدولي) تبقى غالباً بيد القيادات الكردية، لذلك يشعر العرب بأنهم سكان بلا قرار، خصوصاً في مناطقهم، وهذا الشعور بالغبن خلق محاولات تمرد محلية مثل التظاهرات والاحتجاجات، ووصل الأمر ببعض العشائر إلى التحالف مع أطراف أخرى (مثل النظام أو الفصائل المدعومة تركياً) لأسباب مصلحية أو قومية.
وإقصاء العرب من إدارة مناطقهم سبب توترات مع “قسد”، مرجعها الأساس الإقصاء السياسي والتهميش الخدمي وغياب التمثيل الحقيقي، وتحولت إلى أعمال عنف وتمرد، ومثال على ذلك التمرد العشائري في دير الزور في أغسطس (آب) عام 2023، حيث ثار عدد من أبناء قبيلتي البكارة والعكيدات ضد “قسد”، وتبعت ذلك اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر و”قسد”، كما خرجت تظاهرات حاشدة تحمل شعارات من أبرزها “نريد حكماً عربياً للمناطق العربية” و”قسد تهمش أبناء الأرض وتتحكم بالموارد”، وفي تصريحات سابقة لأحد شيوخ عشيرة العكيدات قال إن “العرب مهمشون في الإدارة، وأبناء المنطقة لا يستشارون في شؤونهم، بينما تدار مناطقهم من غرباء، نطالب بخروج غير أبناء المنطقة من دير الزور وبتمكين العرب من إدارة شؤونهم”.
وخلال عامي 2022 و2023، نظمت تظاهرات متكررة في محافظة الرقة تطالب بوقف التجنيد الإجباري وتحسين الخدمات وتمكين العرب من إدارة مناطقهم، وسبق ذلك عام 2021 أن أصدر مجلس قبيلة الولدة (أحد فروع قبيلة العنزة في الرقة) بياناً مما ورد فيه “نرفض التهميش والتجنيد القسري، ونطالب بإدارة محلية نابعة من أبناء المنطقة”.
وللمفارقة، كانت “قسد” خلال هذه الأحداث تتهم جهات خارجية مثل تركيا والنظام السابق وتنظيم “داعش” الإرهابي بتحريض أبناء القبائل ضدها.
التحالف المريب مع النظام السابق
تحالف “قسد” مع النظام السوري السابق هو ملف معقد ومتعدد الأوجه، يراوح ما بين التنسيق المحدود والتحالف التكتيكي، لكنه دائماً كان يثير شكوكاً ومخاوف سواء عند العشائر العربية أو المعارضة أو حتى الدول الداعمة لـ”قسد”.
وكان هذا التحالف “تكتيكياً ليس شاملاً ولا دائماً”، فلم يكُن الطرفان أعداء مباشرين ولا حلفاء استراتيجيين، وإنما تجمعهما تفاهمات أمنية في بعض المناطق، إضافة إلى اتفاقات موقتة إذا كان هناك “خطر” خارجي، وكل ذلك كان يتم بتنسيق من الوسيط الروسي، وأقرب مثال على ذلك، عندما شنت تركيا عملية “نبع السلام” في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، دعت “قسد” النظام إلى الدخول لبعض المناطق مثل منبج وعين العرب، ورفعت أعلام النظام السابق على عدد من مقارها العسكرية لتجنبها الاستهداف التركي، ومن جانب آخر على رغم سيطرة “قسد” على مدينتي الحسكة والقامشلي، فإن النظام كان يسيطر على “مربع أمني” في المدينتين، وكان هذا المربع يتعرض للحصار في كل توتر يحصل بين “قسد” والنظام، فكانت العلاقة بينهما أشبه ما تكون بـ”التعايش”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كان النظام وبسبب العقوبات المفروضة عليه، لا يملك من يصدر لمناطق سيطرته النفط باستثناء إيران، لذلك كان مجبراً على التعامل مع “قسد” واستيراد النفط منها من خلال وسطاء وسماسرة محليين، من أشهرهم حسام قاطرجي “أحد أشهر أمراء الحرب السورية”.
والعشائر العربية كانت تنظر إلى علاقة “قسد” مع النظام على أنها “نفاق سياسي” وفق تعبيرها، لأن “قسد” تقاتل النظام إعلامياً وتنسق معه في الخفاء، كما أن مناطق سيطرتها لم تتعرض على الإطلاق للقصف الذي كان ينفذه النظام على مناطق سيطرة المعارضة، أما أميركياً فكانت واشنطن تدعم “قسد” ضد “داعش”، لكنها لا ترحب بتعاونها مع النظام، ومع ذلك تتغاضى أحياناً عن هذه العلاقات إذا كانت تكتيكية وموقتة. ومع سقوط النظام اعترفت “قسد” على الفور بـ”انتصار الثورة السورية” ورفعت العلم السوري الجديد فوق مقارها ودوائر “الإدارة الذاتية”، وحملت النظام السابق مسؤولية ما آلت إليه البلاد.
والعلاقة المريبة وغير الواضحة لـ”قسد” مع النظام السابق كانت محط جدل وأثارت حفيظة العشائر العربية، فكانت سبباً آخر يدفعها إلى النفور من “قسد”.
الاختلاف الأيديولوجي بين “قسد” والعشائر العربية
الاختلاف الأيديولوجي بين “قسد” والعشائر العربية يمثل أحد أعمق جذور التوتر لأنه لا يتعلق فقط بالسياسة أو النفوذ، بل بفهم مختلف للحياة والمجتمع والسلطة، فـ”قسد” ليست فقط تشكيلاً عسكرياً، بل تستمد فكرها من مشروع سياسي أوسع تقوده “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” التي تقوم على فكر عبدالله أوجلان الذي يُعرف بـ”الفيدرالية الديمقراطية”، ووفق ما تعلنه “الإدارة الذاتية”، فإن رؤيتها تقوم على “رفض الدولة القومية والدعوة إلى حكم ذاتي محلي تشاركي، يعتمد على الإدارة اللامركزية والمساواة الجندرية والعلمانية، ومشاركة كل الإثنيات والأديان في الإدارة”، أما التركيبة الاجتماعية التي تتحدث عنها “قسد” فهي “مجالس محلية منتخبة ومشاركة المرأة إجبارياً بنسبة 50 في المئة ودمج كل المكونات في مؤسسات الدولة”.
في الضفة الأخرى، تعتمد العشائر العربية في شمال شرقي سوريا على نمط تقليدي محافظ قبلي، والسلطة بمنظورها تمارس من قبل الشيوخ ووجهاء العشائر، وتعد الأسرة والقبيلة هي الوحدة الأساس للمجتمع، فيما يتمتع الدين (الإسلام خصوصاً) بمكانة عالية.
وهذا الشرخ الواسع في المفاهيم بين الطرفين سبب نفوراً لدى القبائل العربية من وجود “قسد” في مناطق سيطرتها، ومن أبرز وجوه المقارنة بين الجانبين أن “قسد” ترفض السلطة القبلية باعتبارها “بنية سلطوية ذكورية”، فيما ترى العشائر أن “قسد” تفرض أفكاراً غريبة على بيئة محافظة، وأيضاً تفرض القوات مشاركة النساء في مجالس الحكم، وحتى في العمل العسكري، أما العشائر فترى أن هذا يتجاوز الثوابت الدينية والعرفية لديهم، وأيضاً “قسد” تبعد الدين من التعليم والسياسة، فيما تتهمها العشائر بـ”محاربة الدين” أو في الأقل بـ”تجاهل الإسلام”، وإضافة إلى هذا كله يختلف الخطاب الأيديولوجي بين الطرفين، فتتحدث “قسد” عن مفاهيم مثل “الثورة المجتمعية وتحرر المرأة”، فيما تتحدث العشائر بلغة “الكرامة والشرف والعادات وحماية الهوية العربية والإسلامية”.
كيف يمكن حل القضايا العالقة بين “قسد” والعشائر؟
يرى مراقبون أن حل جميع القضايا العالقة بين “قسد” والعشائر العربية يكمن في خيارين، الأول دمج “قسد” بوزارة الدفاع السورية وعودة مناطق شمال شرقي سوريا لإدارة الحكومة المركزية، وبذلك لن يكون هناك وجود لـ”قسد”، أما الخيار الثاني، فهو إذا بقيت “قسد” ككيان عسكري في مناطقها، فالحل هو أن ينحصر وجودها ضمن المناطق ذات الغالبية الكردية وتحويل إدارة المناطق العربية إلى أبناء المنطقة بالتنسيق مع الحكومة المركزية.
———————————
القمح السوري في سنوات الثورة: عندما عبث النظام بخبز السوريين/ نور ملحم
22 ابريل 2025
يختلف المؤرّخون والأنثروبولوجيون على أشياء كثيرة في تاريخ العالم، لكنهم يتفقون جميعاً، على أن زراعة القمح بدأت من سورية. وأن تدجين هذا النبات العشبي البري، جرى أول مرة قبل 12 ألف عام في منطقة ما في شرق سورية أو غرب العراق (بحسب الخرائط الحالية)، وأن ذلك واحدٌ من أهم التحولات التي جرت على النوع البشري، إذ حوّلته من صياد ملتقط، إلى فلاح مستقر.
دفع ذلك الاكتشاف إلى تغيير نمط حياة الإنسان بالكامل، والانخراط في مجتمعات بشرية أوسع وأكثر تعقيداً، وأن تلك اللحظة التي قدمتها سورية للبشرية، هي نقطة التحول الأساسية في مسار الحضارة. منذ ذلك الوقت، حافظت سورية على مكانها بوصفها أعرق منتج للقمح وأهمّه، ولم تتخلَّ عن ذلك الدور حتى في أحلك حقب التاريخ. ودائماً كانت تنتج خبزها بنفسها، وفي أغلب الفترات كانت تطعم منه الآخرين أيضاً. وما كان لشيء أن يفقدها هذه الميزة، سوى نظام بشّار الأسد، الذي حولها إلى بلد يستورد خبزه، بل يفعل ذلك بشروط مجحفة، وسط أجواء من الفساد والتلاعب والاستغلال.
رحلة استيراد القمح
مع مطلع العام 2012، بدأت سورية رحلتها في استيراد القمح من دول البحر الأسود، (روسيا ورومانيا وأوكرانيا والقرم)، بعد أن كانت عبر التاريخ من الدول الرائدة في إنتاج القمح وتصديره… ووفقاً لتصريح رئيس شركة “إيكار” للاستشارات الزراعية (إحدى الشركات المصدرة للقمح الروسي إلى سورية)، دمتري ريلكو، لوكالة تاس الروسية، تحتل سورية اليوم المرتبة الـ 24 بين مستوردي القمح الروسي باستهلاك سنوي يبلغ مليوني طن، ويعود هذا التحول إلى انخفاض إنتاج القمح محلياً إلى أقل من مليون طن سنوياً، بعدما كان يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن قبل عام 2011.
بدأت حكومة النظام السابق منذ 2017 اعتماد عقود حصرية مع روسيا لتأمين القمح. وبحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (في حكومة النظام السابق)، عبد الله الغربي، جرى توقيع اتفاقية لاستيراد ثلاثة ملايين طن من القمح الروسي على مدى ثلاث سنوات (2017- 2018-2019)، بقيمة تبلغ نحو 494.25 مليون يورو، مع تسهيلات دفع تمتد ثماني سنوات. يبلغ سعر طن القمح حوالي 164.75 يورو، ما يعادل 99 ليرة سورية للكيلوغرام (بسعر صرف 600 ليرة سورية لليورو).
سلة الخبز الإقليمية
يعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية في سورية، وكان متوسط إنتاجها قبل الحرب أربعة ملايين طن، ووصلت في بعض السنوات إلى ما يقرب 5 ملايين طن. كان يستهلك منها 2.5 مليون طن محلياً، فيما يصدر الفائض، كانت سورية تُعرف بأنها “سلة الخبز الإقليمية”، بفضل إنتاج وفير من الحبوب تجاوز الاحتياجات المحلية، ووفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة، حافظت البلاد على مساحة مزروعة بالقمح بلغت نحو 1.6 مليون هكتار، 43% منها أراضٍ مروية و57% بعلية تعتمد على الأمطار. خلال تلك الفترة (1990-2011)، بلغ متوسط إنتاج القمح نحو أربعة ملايين طن سنوياً، وبلغ ذروته عام 2006 بإنتاج 4.9 ملايين طن.
اتبعت الحكومة آنذاك سياسة شراء جميع المحاصيل من المزارعين، حيث كانت تتسلّم 2.5 مليون طن سنوياً لتموين الأفران والاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لعامين، فيما كانت تصدّر نحو 1.5 مليون طن لدول مثل مصر واليمن والأردن.
بداية التراجع
وفقاً للمهندس الزراعي محمد رامز خضر (موظف سابق في مديرية زراعة دمشق)، بدأ إنتاج القمح بالتراجع في السنوات الثلاث التي سبقت الثورة السورية عام 2011. وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الوقود والأسمدة، فضلاً عن تأثير الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة، وأدّى إلى هجرة آلاف الفلاحين من منطقة الجزيرة السورية، التي تنتج أكثر من 70% من الإنتاج الوطني. لافتاً أنه، في عام 2008، ظهرت مؤشّرات أولية للتراجع عندما بدأت سورية استيراد القمح لأول مرة، مع استقبالها 1.2 مليون طن من بلغاريا عام 2009. وتراجعت الكميات المسلّمة من المزارعين إلى 2.4 مليون طن في 2010 مقارنة بـ2.8 مليون طن في العام 2009. وأفاد الخبير الزراعي بأن تزايد الاعتماد على الاستيراد مع بداية عام 2011، مع تفاقم الصراع، أصبح استيراد القمح ضرورة مُلحّة، حيث تركزت الزراعة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بحوالي 700 ألف طن من المحصول الإجمالي، أما المحافظات الشرقية الرئيسية “الحسكة، الرقة، دير الزور” فقد خرجت عن السيطرة، وأصبحت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، وهي التي تنتج حوالي 70% من إجمالي الإنتاج. الأمر الذي دفع الحكومة السورية منذ عام 2011 إلى استيراد احتياجها من القمح عبر شركات وسيطة من أجل التحايل على العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية منذ ذلك التاريخ، وكانت الحكومة السورية تستورد القمح من معظم دول البحر الأسود ومن خلال مناقصات للحصول على أدنى سعر، ولكن في عام 2017 تم حصر الاستيراد من روسيا فقط.
ووفقاً لبيانات “بيزنس إنسايدر”، بلغ سعر القمح في بورصة شيكاغو 228.13 دولاراً للطن في 2024، بينما بلغ سعر القمح الروسي المصدّر إلى سورية 345 دولاراً للطن في العام نفسه، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “سي تي غي إينجينيرينغ” الروسية، دميتري تريفونوف. ويمثّل هذا السعر زيادة قدرها مائة دولار مقارنة بسعر القمح الروسي المصدّر إلى مصر، والذي يبلغ 245 دولاراً للطن وفقاً للشركة نفسها.
إحصاءات
وقال المدير العام السابق لمؤسسة الحبوب، يوسف قاسم لـ “سورية الجديدة” إن النزاع تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية، إلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية، الفساد، الانقسامات الإقليمية، النزوح الجماعي، كما ساهمت الظروف الجوية السيئة والحرائق في انخفاض إنتاج القمح بنسبة تجاوزت النصف تقريباً. ووفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة، بلغت مساحة الأراضي السليخ المزروعة فعلاً خلال الموسم الزراعي 2023 ــ 2024 نحو 3,134,469 هكتاراً، منها 1,276,409 هكتار مخصصة لزراعة القمح، أي ما يعادل 40.7% من إجمالي الأراضي المزروعة. وتصدرت محافظة الحسكة قائمة المناطق المزروعة بالقمح بنسبة 36.7% من إجمالي المساحات، تلتها محافظة الرقة بـ16.8%، ثم محافظة حلب بنسبة 14.4%.
شهدت المساحات المزروعة بالقمح انخفاضاً بنسبة 33% بين عامي 2005 و2024. ففي عام 2005، بلغت المساحة المزروعة 1,904 ألف هكتار، بينما تقلصت إلى 1,276 ألف هكتار في عام 2024. كما تناقصت الكميات المسوقة إلى كل من المؤسسة السورية للحبوب ومؤسسة إكثار البذار من 70% في عام 2005 إلى 35% في الموسم الزراعي الماضي.
حصر العقود مع الشركات الروسية
وقال القاسم إن الحكومة السورية اعتمدت منذ عام 2017 على استيراد القمح من روسيا بشكل حصري، بكميات راوحت بين 1.2 و1.5 مليون طن سنوياً. وقد أدّى حصر العقود على الشركات الروسية إلى استغلال الوضع، حيث بيع القمح بأسعار أعلى من السوق العالمية.
وفي عام 2018، أعلنت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لحكومة الأسد أولَ عقد استيراد مائتي ألف طن من القمح الروسي بسعر 224 دولاراً للطن الواحد، وهو سعر يزيد بنحو 31 دولاراً عن السعر العالمي آنذاك. في المقابل بلغ سعر القمح الروسي المصدر إلى مصر 215 دولاراً للطن الواحد، وفقاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ما يظهر تفاوتاً واضحاً في الأسعار. وأمّا ما يخص الخسائر الاقتصادية الكبيرة في عام 2023، فقد استوردت سورية نحو 1.4 مليون طن من القمح الروسي. ووفقاً لتقدير السعر الوسطي للطن بـ250 دولاراً، بلغ إجمالي تكلفة العقد نحو 350 مليون دولار. هذا الرقم يُعتبر ضخماً مقارنة بميزانية سورية المبدئية لعام 2024، التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار (وفق سعر الصرف في السوق السوداء).
وبحسب الخبير الزراعي المهندس محمد رامز الخضر، فإن السياسات التي كانت متبعة من قبل النظام السابق أسهمت في تقليص زراعة القمح المحلي، دعماً لمصالح أقلية من التجار المرتبطين بالنظام، فضلاً عن المكاسب التي تحققها روسيا شريكاً رئيسياً في هذه العقود، ما يعزز العلاقة التحالفيّة بين الطرفين. وفي المقابل كشف، المدير العام السابق لمؤسسة الحبوب، أن روسيا فرضت شروطاً مشددة على القروض التي قدمتها للحكومة السورية في عام 2020، حيث اشترطت استخدام هذه القروض حصرياً لاستيراد مواد ذات منشأ روسي عبر شركات محددة. تضمنت هذه الاتفاقيات استيراد مليون طن من القمح بأسعار تفوق السوق العالمية، في ظل معاناة النظام من نقص الإيرادات ومحدودية وصوله إلى العملات الأجنبية، مما عزز نفوذ روسيا في تجارة القمح في سورية.
أسعار أعلى من السوق الدولية
عرضت شركة OZK الروسية، في إبريل/ نيسان 2021، القمح على الجانب السوري بسعر 355 دولاراً للطن، رغم اتفاق سابق على سعر 340 دولاراً، وبعد التفاوض، تم الاتفاق على 350 دولاراً للطن، بينما كانت أسعار القمح العالمية لا تتجاوز 257 دولاراً للطن في الشهر نفسه. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، قدّمت شركة STG Engineering عرضاً بسعر 319 دولاراً للطن، في وقت لم يكن فيه سعر السوق العالمي يتخطى 283 دولاراً، وفي ديسمبر/ كانون الأول، عرضت “OZK” القمح بسعر 317 دولاراً للطن، بينما بلغ سعر السوق الدولي أقل من 290 دولاراً في تلك الفترة.
حيث تتم توريدات القمح الروسي إلى سورية بشكل رئيسي عبر شركتي STG Engineering وشركة المتحدة للحبوب، التي كان مقرها بريف دمشق، برئاسة رجل الأعمال فراس بدرا حتى عام 2017. (بحسب مدير عام سابق في وزارة الزراعة). في المقابل، تواصل شركة STG Engineering تصدير القمح إلى سورية منذ ثلاث سنوات، (وتعود ملكية الشركة إلى جينادي تيمشينكو، الملياردير والصديق الشخصي لبوتين). وأضاف تريفونوف أن الشركة لديها ديون على الحكومة السورية بقيمة 116 مليون دولار، ورغم أن أسعارها تزيد “قليلاً” عن السوق، قدّمت تسهيلات دفع مريحة من دون طلب ضمانات مسبقة، وبلغ سعر طن القمح الذي تبيعه الشركة لسورية 345 دولاراً، وهو ما وصفه بأنه يتناسب مع طبيعة الاتفاقيات المعقودة.
ووفقاً لتفاصيل القروض الروسية، كان من المُتوقع أن يتم سدادها على مدى عشر سنوات بأقساط نصف سنوية، مع أسعار فائدة تبدأ من 1.5% في السنة الأولى وتصل إلى 8% بحلول عام 2033. وعن فروق في الأسعار والتساؤلات المطروحة علق وزير الزراعة الأسبق نور الدين منى على الأسعار المرتفعة للقمح الروسي، وقال لـ “سورية الجديدة” إن سعر الطن في السوق العالمية راوح بين 220 و240 دولاراً في 2021، بحسب نوع القمح ومصدره. واستنكر منى الفارق الذي يتجاوز 40 دولاراً للطن، متسائلاً: “كيف دفعت سورية هذا المبلغ؟ أين يذهب الفرق؟!”.
لجنة القمح ودورها في عقود الاستيراد
استمرّت سورية في شراء القمح الروسي بأسعار تفوق السوق العالمية، حيث راوح الفرق في السعر بين 40 و100 دولار للطن، وأكّد مصدر (كان ضمن فريق حكومة حسين عرنوس)، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن لجنة القمح التابعة للقصر الجمهوري هي المسؤولة عن قرارات الاستيراد والتصدير، وتتألف من وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير الاقتصاد سامر خليل، وحاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيم. وقال المصدر لـ “سورية الجديدة” إن العقود تُنفذ غالباً عبر السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد الذي يوقع الاتفاقيات. وأوضح المصدر المسؤول أن الوضع المالي المتعلق باستيراد القمح في سورية كان في غاية التعقيد، نظراً إلى عدم توفر العملة الأجنبية، ما يضطر الحكومة إلى قبول الأسعار والشروط المرتفعة، وأضاف أن العقوبات الاقتصادية تزيد من تكاليف النقل وتحد من قدرة سورية على إيجاد شركاء تجاريين دوليين، وفي ظل هذه الظروف، اقترحت الحكومة السورية توقيع خط ائتمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستيراد القمح، إلا أن الكرملين الروسي رفض ذلك نتيجة الحرب الأوكرانية.
استيراد القمح أسهل قبل حصره بدولة
وقال المدير السابق لمؤسسة الحبوب، يوسف قاسم، إن استيراد القمح كان أسهل وأبسط قبل حصره بدولة واحدة، موضحاً أن سورية كانت تستورد القمح من مختلف دول البحر الأسود بأسعار قريبة من السوق العالمية، مع زيادة تراوح بين دولارين إلى عشرة دولارات للطن. وأفاد القاسم بأن الاستيراد كان يتم عبر شركات وساطة خاصة، معظمها في لبنان والإمارات، يتم الاستعانة بها للالتفاف على العقوبات الاقتصادية، ويرى القاسم أن قرار حصر الاستيراد من روسيا فقط فتح الباب أمام استغلال الشركات الروسية، حيث بدأت تبيع القمح بأسعار أعلى بكثير من السوق العالمية. وأضاف أن روسيا، التي قدمت القروض للحكومة السورية، اشترطت استخدام أموال القروض حصرياً للدفع لشركات روسية محدّدة بالتعاون مع لجنة القمح التابعة للقصر الجمهوري، التي يرأسها وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزّام. ومع انخفاض الإيرادات والعملة الأجنبية نتيجة الصراع، وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى قبول شروط تمويل مجحفة لتأمين السلع الأساسية مثل القمح.
وبحسب المسؤول السابق، تمت صفقات بأسعار مرتفعة في عام 2022، إذ أبرمت سورية عقدين لاستيراد القمح مع شركتين روسيتين بكمية إجمالية بلغت 1.4 مليون طن، مع زيادة تصل إلى 25% عن الأسعار العالمية، وبلغ سعر الطن 350 دولاراً مقابل 250 دولاراً في السوق الدولية، وفي عام 2024، تم توقيع عقدين آخرين مع الشركتين نفسيهما بكمية إجمالية 700 ألف طن، نُفذ منها 500 ألف طن فقط، بالأسعار المرتفعة نفسها بحجة التسديد الآجل وقد بلغ إجمالي العقود مليوني طن ومائة ألف وتم تنفيذها بواسطة رئيس لجنة القمح في القصر الجمهوري.
تحدّي العقوبات
أظهرت بيانات منصة Refinitiv Eikon، التي توفر وصولاً غير محدود إلى الإحصائيات المالية وأسواق الشحن، أن سورية وروسيا اعتمدتا بشكل متزايد على سفنهما الخاصة لنقل القمح، بما في ذلك ثلاث سفن سورية مشمولة بالعقوبات الأميركية، تأتي هذه الخطوة في ظل العقوبات المفروضة على البلدين، التي صعّبت التجارة عبر طرق النقل البحرية المعتادة، وأعاقت الحصول على تأمين ملاحي. حيث شهدت كميات القمح المرسلة إلى سورية من ميناء سيفاستوبول في القرم المطل على البحر الأسود ارتفاعاً كبيراً في عام 2022 مقارنة بعام 2021، إذ زادت بمقدار 17 ضعفاً مقارنة بالسنوات السابقة، لتصل إلى 1,4 مليون طن. وتمثل هذه الكمية حوالي ثلث إجمالي واردات سورية من القمح. وتولت عمليات استيراد القمح شركات روسية مثل “سوليد1” و”سيستوس”، بالإضافة إلى شركات روسية – سورية أخرى، ما يعكس التعاون المتزايد بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليهما.
وأكد الخبير الاقتصادي والمدرس في جامعة قاسيون بدمشق، عمر الجندي، أن روسيا تسيطر بشكل كبير على سوق تصدير القمح العالمي. وقال لـ”سورية الجديدة” إن السوق السورية أصبحت وجهة جديدة للقمح الروسي، ما وفّر للشركات الروسية فرصاً استثمارية مميزة ومربحة. وأوضح الجندي أن استيراد القمح من روسيا يواجه تحدّيات عدة، منها مشكلات التحويل البنكي وصعوبة تأمين النقل عبر البحر الأسود. ورغم ذلك، استغلت روسيا حاجة سورية الماسة إلى القمح ورفعت أسعاره بشكل كبير. وبيّن أن تكلفة استيراد مليون ونصف مليون طن من القمح الروسي زادت بأكثر من 150 مليون دولار، وهو مبلغ كان يمكن استخدامه لاستيراد كميات إضافية من السوق العالمية تصل إلى 580 ألف طن، لولا سياسة حصر الاستيراد من روسيا التي اتبعتها الحكومة السورية لتسديد ديونها المستحقة لروسيا جرّاء الحرب.
تدمير الزراعة المحلية وسورية دولة مستوردة
وأفاد الجندي بأن السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل نظام الأسد ساهمت في تدمير قطاع الزراعة ورفع الدعم عن الفلاحين، مما أدى إلى تقليص الإنتاج المحلي من القمح بشكل حاد. وفي عام 2019، نُقل ملف القمح بالكامل إلى القصر الجمهوري، حيث استخدمت روسيا صادرات القمح لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الحصول على النقد الأجنبي، من خلال الدفع النقدي ثم رفع الأسعار تدريجياً بحجة التسديد الآجل. وتخفيف أعباء التسديد عبر المقايضة، بمبادلة القمح السوري القاسي بكميات من القمح الطري الضروري لصناعة الخبز. وتأمين احتياجات النظام السوري الغذائية، لضمان استمراره وتجنب المجاعات التي قد تستدعي تدخلاً دولياً يضر بمصالحها.
وقال الخبير الزراعي والمدرس في جامعة حلب، المهندس أكرم العبد الله، لـ”سورية الجديدة” إن الحرب أدخلت سورية في نفق مظلم لتأمين احتياجاتها من القمح، بعد خسارة المخزون الاستراتيجي وتحولها إلى دولة تعتمد بالكامل على استيراد القمح الروسي، وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة السورية. وأفاد بأن العقود والمناقصات غالباً ما تُمنح لشركات روسية بفضل التفضيلات السياسية والاقتصادية، مضيفاً أن القمح السوري القاسي، الذي يُعتبر من أفضل أنواع القمح عالمياً، كان يُباع إلى الدول الأوروبية بأسعار مرتفعة، بينما تستورد سورية القمح الطري المنخفض الجودة. ولفت العبد الله إلى وجود تلاعب في أرقام الإنتاج المحلي بهدف تبرير استيراد القمح الروسي، مؤكّداً أن المسؤولين يتجنبون التصريح بالكميات والأسعار. وتساءل عن مستقبل الأمن الغذائي في سورية وسط السياسات الاقتصادية والزراعية المتدهورة، محذّراً من استمرار العجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.
فطر الأرغوت… سمٌ أكلناه مع الخبز الروسي
لم تقتصر الصفقات والعقود الموقعة لاستيراد القمح من روسيا على ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، بل شملت أيضاً تجاوزات خطيرة للمعايير والمقاييس المعتمدة للاستخدام البشري، وفقاً لوثيقة صادرة عن مركز الأبحاث الحكومية السورية حصل عليها “سورية الجديدة”، وأوضحت أن رئاسة الحكومة السورية في عهد نظام بشّار الأسد خالفت القوانين والأنظمة في صفقات توريد القمح والطحين، بما في ذلك إلغاء شرط فحص المواد الغذائية بعد وصولها إلى البلاد قادمة من روسيا، في مخالفة واضحة لدفاتر الشروط المعتمدة، وتُظهر الوثيقة أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة الرقة أكّدت في 20 إبريل/ نيسان 2015، أن الجهات الرسمية استوردت قمحاً وطحيناً مصابَين بفطر الأرغوت السام عبر شركتَي الفوز وغرناطة. وتعود ملكية الأولى لرجل الأعمال سامر الفوز، المقرّب من نظام الأسد، والذي توسعت استثماراته في مجالات عدة مثل توريد القمح، وصناعة الأدوية، والقرى السياحية، وتجارة السكر. ويملك شركة غرناطة المساهم الكويتي رياض فرحان خليف شبيلي العنزي بنسبة 60%، فيما يملك اسكندر غنوم النسبة المتبقية.
بحسب التقرير، أدخل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي (آنذاك) أحمد القادري، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، شحنة قمح طري مصابة بفطر الأرغوت، بناءً على تحليل مخبر خاص، ليجري إرسالها إلى المطحنة مباشرة من دون المرور بمستودعات مؤسسة الحبوب أو شركة الصوامع، وهو ما أثار مخاوف صحية كبيرة.
وفي عام 2020، كرّرت الحكومة السورية هذه المخالفات عندما استورد يسار إبراهيم، مدير المكتب المالي والاقتصادي لرئاسة الجمهورية، شحنة من القمح الروسي المخالف للمواصفات المعتمدة للاستهلاك البشري. وبضغط من القصر الجمهوري، جرى الالتفاف على القوانين السورية، وتفريغ الشحنة في مطحنة خاصة بمحافظة طرطوس، بعد رفض المؤسسة العامة للحبوب استلامها، حسب المدير العام السابق.
حذر أستاذ العلوم البيئية والزراعة العضوية في جامعة دمشق محمد الأبرشي، من خطر دخول فطر الأرغوت إلى سورية، موضحاً أن هذا يسبّب أمراضاً خطيرة تصيب النباتات العشبية، خاصة عائلات القمح والشعير والذرة الرفيعة، وأفاد بأن فطر الأرغوت يصيب بين 5% و10% من الحبوب عالمياً، ما يدفع دولاً عديدة إلى منع تداول الحبوب التي تحتوي على أي نسبة منه، نظراً إلى تأثيراته السلبية الخطيرة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وأكد أن سورية تُعدّ من الدول الخالية من هذا الفطر، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير مشددة لمنع دخوله إلى البلاد. وقال الأبرشي إن فطر الأرغوت يُعد شديد السُّمية على الإنسان، إذ يحوّل حبة القمح إلى جسم حجري بفعل مكونات الفطر، ما يؤدّي إلى تدمير الأنسجة العصبية، ويسبّب الشلل وضعف الدورة الدموية، ويمكن أن يُحدث غرغرينا في أصابع اليدين والقدمين.
وبالنسبة للحيوانات، يتسبّب الفطر بخسائر اقتصادية كبيرة. على سبيل المثال، يؤدّي تناول الدواجن أعلافاً مصابة بالأرغوت إلى مشكلات تنفسية حادة وإسهال شديد يفضي إلى الموت الجماعي، كما يسبّب إجهاضاً في الماشية، وانخفاضاً في إدرار اللبن، بالإضافة إلى إصابتها بالإسهال الشديد الذي قد يؤدّي إلى الوفاة.
العربي الجديد
——————————-
إعادة تموضع أميركية في سوريا | واشنطن تغري دمشق: الانسحاب مقابل التطبيع
بدأت الولايات المتحدة خطة لتنفيذ انسحاب جزئي من سوريا على ثلاث مراحل، في انتظار تقييم جديد خلال 60 يوماً، يُحتمل أن ينتهي بالإبقاء على نحو 500 جندي أميركي فقط في الداخل السوري وعدد محدود من القواعد في سوريا، في خطة تهدف إلى تلبية رغبة الرئيس دونالد ترامب في تخفيض التدخل العسكري في الدول الأجنبية. ويأتي هذا في ظلّ تسارع التحولات الإقليمية، وسعي واشنطن لتمرير عرض سياسي – أمني متكامل إلى دمشق، عنوانه الظاهر تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، فيما مضمونه الحقيقي استدراج السلطة الجديدة نحو التموضع في المحور الأميركي، على قاعدة التطبيع مع إسرائيل والعداء الكامل لإيران.
وبالفعل، بدأت الولايات المتحدة انسحاباً جزئياً من خلال إخلاء شبه كامل لأكبر قاعدتين في سوريا، هما: «القرية الخضراء»، المعروفة بـ«العمر» في ريف دير الزور الشرقي، و«الفرات» والمعروفة بـ«معمل غاز كونيكو» في ريف دير الزور الشمالي، بالإضافة إلى قاعدة ثالثة بالقرب من بلدة الباغوز على الحدود السورية العراقية، علماً أن الجنود المتواجدين في تلك القواعد انسحبوا في مسارين: الأول في اتجاه «الشدادي» لتعزيزها، والآخر في اتجاه القواعد الأميركية في كردستان العراق، حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين بارزين. وأوضح المسؤولون أنه «بهذا التحرك، انخفض عدد أفراد الجيش الأميركي من 2000 جندي إلى 1400 جندي». وأضاف هؤلاء أن «القادة العسكريين سيعيدون تقييم الوضع بعد 60 يوماً (…) وسيوصون ببقاء ما لا يقل عن 500 جندي في المنطقة لاحقاً».
بدورها، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بياناً أعلنت فيه أنه «سيتم تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر القادمة»، في خطوة وصفتها بأنها «عملية مدروسة ومشروطة». كما أعلن المتحدّث الرسمي الرئيسي للوزارة، شون بارنيل، عن «توحيد القوات في سوريا تحت قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، في مواقع مختارة». ورأى أن هذا الإجراء «يعكس الخطوات الكبيرة التي قطعناها نحو تقليص جاذبية «داعش» وقدراته التشغيلية إقليمياً وعالمياً».
ويأتي ذلك فيما يبدو أن الأميركيين يواصلون سعيهم لاستمالة الإدارة السورية الجديدة، واستثمار سيطرتها على العاصمة دمشق، لإنهاء وجود حركات المقاومة الفلسطينية هناك، بالإضافة إلى دفع التطبيع مع إسرائيل، وتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» على لائحة الإرهاب، وفقاً لوثيقة مسرّبة لقائمة من المطالب الأميركية من سوريا، مقابل إمكانية رفع العقوبات عن الأخيرة بشكل تدريجي.
ويُحتمل، هنا، أن تكون واشنطن قد نفّذت هذا الانسحاب الجزئي لتأكيد جدية احتمال تسليم دمشق آبار النفط أيضاً، مقابل ضمان قيام نظام سياسي صديق لأميركا وإسرائيل، وخصوصاً أن القاعدتين اللتين تم الانسحاب منهما تقعان في أغزر مناطق انتشار النفط والغاز. كما أن توحيدها القوات العاملة في سوريا تحت لواء عملية «العزم الصلب»، يستبطن رسالة باستعدادها لحماية إدارة الرئيس السوري في الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، من هجمات «داعش» – بعد إعلان الأخير الحرب على دمشق -، وأنها تريد منه التعاون لإنهاء نشاط التنظيم في سوريا ومنع استغلاله للأوضاع الأمنية للعودة من جديد.
ومع ذلك، لم ينعكس الانسحاب الأميركي هدوءاً تاماً على الأرض؛ إذ نفّذت قوات أميركية، برفقة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، جولات على سرير نهر الفرات في دير الزور، وفي بلدة تل تمر في ريف الحسكة، توازياً مع إجراء تدريبات ونقل أسلحة في عدة «قواعد» في ريف الحسكة، وتنفيذ حملة أمنية في مخيم الهول ضد خلايا تنظيم «داعش». وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ خطة لإعادة انتشار في سوريا، كانت مُعدّة حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض» موضحة أن «الخطة تقوم على انسحاب من قواعد ودمج أخرى، وتقليص عدد الجنود الأميركيين من ألفين إلى 500 جندي فقط»، علماً أنه قبل سقوط نظام الأسد بأشهر، رفعت واشنطن عدد جنودها من 900 إلى ألفين.
وتضيف المصادر نفسها أن واشنطن «ستحتفظ بثلاث قواعد رئيسية، هي: قسرك في ريف الحسكة الشمالي الغربي، والشدادي في جنوب الحسكة، مع إنشاء قاعدة جديدة في سد تشرين بريف حلب الشمالي الشرقي»، مرجّحة أن «تركّز في وجودها على استمرار مراقبة أمن مخيمات وسجون تنظيم داعش في مناطق سيطرة قسد في سوريا». وتتوقّع أن «تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 500 جندي، إلى حين استكمال دمج «قسد» في بنية الدولة السورية الجديدة بما يتيح استكمال العمليات ضد تنظيم داعش»، معتبرة أن «هذه القواعد ستبقى أيضاً نقطة ضغط متواصلة على دمشق لدفعها إلى الانخراط في المحور الأميركي، وعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل».
——————————-
هل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟/ نديم شنر
22/4/2025
في مقالي السابق على الجزيرة نت تحدّثت عن تقاطع المصالح بين إسرائيل وتركيا في الملفّ السوري، متناولًا السيناريوهات السيئة المحتملة، فقلت: “لم تُغيّر إسرائيل من إستراتيجيتها باستخدام نفوذها على الإدارة الأميركية، أو استخدام فرع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا، كأداة لتنفيذ سياساتها.
أما الشرور التي قد تقدم عليها فهي واضحة: تنفيذ عمليات تخريب واغتيالات بغرض تغيير الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع في سوريا، وافتعال أعمال استفزازية باستخدام تنظيم PKK الذي يُتوقع أن يعلن حله قريبًا. فكل شيء قد يتغير، إلا إسرائيل التي تدين بوجودها للاحتلال والإبادة؛ فهي لا تتغير”.
لم أكن أتوقع أن تتحقق توقعاتي بهذه السرعة، لكن الحقيقة أنه لا حاجة لأن تكون “منجمًا” لتتوقع أفعال إسرائيل، فمجرد مراقبتها يكفي.
وهكذا، كما توقعت، أقدمت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي على استفزاز جديد.
نُشرَ أول الأخبار عن ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث أفاد موقع “Ynet” أن مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بنيّة الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا تدريجيًا خلال شهرين.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الإسرائيلية لمنع هذا الانسحاب من خلال ضغط دبلوماسي على واشنطن، فإن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها.
وبحسب التقرير، فإن الأوساط الأمنية في إسرائيل ما زالت تواصل ضغوطها على الإدارة الأميركية.
لاحقًا، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” خبرًا يؤكد أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية انسحاب تدريجي من سوريا. وبموجب هذا القرار، سيتم تخفيض عدد الجنود الأميركيين في سوريا من حوالي 2000 جندي إلى 1400، وستُغلق ثلاث قواعد عسكرية من أصل ثمانٍ.
ومن المقرر إجراء تقييم لاحقًا بشأن إمكانية سحب المزيد من الجنود. ومع ذلك، أوصى مسؤولو البنتاغون بالإبقاء على ما لا يقل عن 500 جندي في سوريا.
وفي خضم هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 18 أبريل/ نيسان بيانًا غير اعتيادي حذرت فيه من احتمال وقوع هجوم في العاصمة السورية دمشق.
وأشارت الوزارة إلى معلومات استخبارية موثوقة عن احتمال وقوع هجمات في أي وقت، حتى في أماكن يزورها السياح بشكل متكرر.
وتوقَّعت الوزارةُ أن تشمل الهجمات فعاليات عامة، فنادق، أندية، مطاعم، أماكن عبادة، مدارس، حدائق، مراكز تسوق، أنظمة نقل عام، وأماكن مكتظة، وقد تقع هذه الهجمات دون سابق إنذار.
بطبيعة الحال، تبادر إلى أذهان الكثيرين أن إسرائيل قد تكون وراء هذه الهجمات المحتملة.
ومن الواضح أن هذه التهديدات تأتي في سياق محاولة إسرائيلية استفزازية لعرقلة انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. فهذه الرسائل، التي تستهدف دمشق، موجهة في الوقت ذاته إلى تركيا، وكذلك إلى الرئيس الأميركي ترامب، الذي لم يستجب لمطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
فحكومة نتنياهو ترى في مثل هذا الهجوم فرصة لجرّ تركيا إلى صراع من شأنه أن يوقف قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، ولذلك أعدّت هذا الاستفزاز بعناية.
فالرئيس الأميركي ترامب كان قد صدم نتنياهو بموقفه من السياسة السورية بقوله: “لديّ علاقة رائعة مع رجل يُدعى أردوغان. هل سمعتم بهذا الاسم؟ أنا أحبه، وهو يحبني. أعلم أن الصحافة ستغضب مني، سيقولون: “ترامب يحب أردوغان!” لكنني أحبه، وهو يحبني. لم نواجه أي مشكلات من قبل. عشنا تجارب كثيرة، لكن لم تحدث بيننا مشكلات. وأتذكر أننا استعدنا القس الأميركي من تركيا في ذلك الوقت، وكانت خطوة كبيرة.
قلت لرئيس الوزراء (نتنياهو): “بيبي”، إن كانت لديك مشكلة مع تركيا فأعتقد أن بإمكاني حلّها. لديّ علاقة ممتازة جدًا مع تركيا ومع زعيمها. أظن أننا نستطيع حل الأمور معًا”.
ونقل ترامب أيضًا حوارًا دار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال: “هنّأته وقلت له إنه فعل ما لم يفعله أحد منذ ألفي عام. لقد أخذت سوريا، قلت له، بأسماء مختلفة، لكن بنفس المعنى. قال لي: لا، لا، لم أكن أنا. فأجبته: لا بأس، لقد كنتَ أنت، لكن لا مشكلة. فقال: نعم، ربما كنت أنا بطريقة ما”.
وأضاف ترامب: “انظروا، إنه رجل صارم وذكي جدًا. فعل ما لم يستطع أحد فعله، ويجب الاعتراف بذلك.” ثم التفت إلى نتنياهو وقال: “أعتقد أنني قادر على حل أي مشكلة بينك وبين تركيا، ما دمت منطقيًا. عليك أن تكون معقولًا. يجب أن نكون معقولين”.
بعد هذه التصريحات، انهالت الانتقادات في الإعلام الإسرائيلي، بأن إسرائيل لم تعد قادرة على استخدام نفوذها الكامل على الولايات المتحدة.
لكن قوة إسرائيل لا تنبع فقط من اعتمادها على الوجود العسكري الأميركي، بل تمتد إلى شبكات استخباراتية واسعة تديرها عبر جهاز الموساد في الشرق الأوسط، مما يمنحها قدرة هائلة على إثارة الفوضى.
وتشمل هذه القوة تجنيد العملاء، استخدام تقنيات الحرب الخفية، تنفيذ عمليات اغتيال، وتوجيه حملات دعائية إعلامية.
كما أن الأساطيل الحربية الأميركية في البحر المتوسط والقواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة تبقى في حالة استعداد دائم لأي طارئ يهدد إسرائيل، مما يمنحها شعورًا دائمًا بالأمان لتنفيذ استفزازاتها، بما في ذلك قصف دمشق.
وهكذا، تمكنت إسرائيل من تنفيذ جرائمها في غزة، واحتلال المناطق العازلة حول مرتفعات الجولان في لبنان، وسوريا.
ورغم كل هذا، يُصر الرئيس ترامب على قراره المتكرر بسحب القوات الأميركية من سوريا.
وما كشفته وزارة الخارجية الأميركية حول استعداد إسرائيل لضرب دمشق، يعكس بوضوح الخلاف المتنامي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي نفس اليوم، 18 أبريل/نيسان، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيانًا رسميًا يُظهر نيتها عدم الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي، وأعلنت أنها ستخفض عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي.
وجاء في البيان:
“في ضوء النجاحات التي تحققت ضد تنظيم الدولة، بما في ذلك فقدان التنظيم لسيطرته الإقليمية خلال فترة حكم الرئيس ترامب في عام 2019، أصدر وزير الدفاع تعليمات بإعادة تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، لتكون أكثر تركيزًا. تعكس هذه الخطوة التقدم الكبير في تقليص قدرة تنظيم الدولة على المستويين؛ الإقليمي والعالمي.
هذه العملية ستكون متعمدة وتستند إلى الظروف، وستؤدي في الأشهر القادمة إلى تقليص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى حوالي 1000 عنصر.
وفي الوقت نفسه، ستواصل القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات جوية ضد فلول تنظيم الدولة، مع استمرار التعاون الوثيق مع شركائنا في التحالف الراغبين والقادرين على مواصلة الضغط على التنظيم والتصدي لأي تهديدات إرهابية جديدة”.
فهل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟
في عامي 2018 و2019، أعلن ترامب مرتين نيته سحب القوات من سوريا، لكنه لم ينجح. وفي عام 2020، صرّح جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا حينها، بأنهم كانوا يتلاعبون بالأرقام لإخفاء العدد الحقيقي للقوات الأميركية في سوريا عن ترامب، قائلًا: “كنا دائمًا نلعب ألعابًا لخداع القيادة الأميركية بشأن عدد قواتنا هناك. في الواقع، كان عددهم أكبر بكثير من الرقم الذي وعد ترامب به، وهو 200 جندي فقط”.
وأضاف في مقابلة مع موقع Defence One: “ترامب كان ميّالًا للانسحاب بعد دحر تنظيم الدولة، فقررنا في كل مرة أن نجهز خمس حجج أفضل لنبقى هناك، وقد نجحنا في مرتين. هذه هي القصة”.
تصريحات جيفري تؤكد قناعتي بأنه: في أميركا يمكنك أن تُنتخب رئيسًا، لكن لا يمكنك أن تحكم كرئيس. حتى وإن امتلكت السلطة، فقد لا تتمكن من استخدامها، وتظن فقط أنك تستخدمها.
اليوم، إسرائيل هي العامل الأكبر في عرقلة انسحاب أميركا من سوريا، بينما تركيا هي القوة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا الانسحاب.
فإسرائيل لن تتخلى عن مشروعها الصهيوني الممتد منذ 150 عامًا لتحقيق حلم “أرض الميعاد”، ولذلك حتى لو خفضت أميركا أعداد جنودها، فلن تنهي وجودها العسكري الذي يُتيح لها التدخل في أي لحظة.
وتؤكد آلاف الشاحنات المحمّلة بالأسلحة والذخائر التي زودت بها أميركا مليشيات: PKK وPYD وYPG منذ عام 2013، على استمرار هذا الدعم.
وما دامت إسرائيل مستمرة في نهج الاحتلال، فستستمر في الضغط على أميركا أيضًا، مستفيدة من تغلغلها العميق في مفاصل القرار الأميركي؛ في السياسة، والاستخبارات (CIA)، والدفاع (البنتاغون)، ووسائل الإعلام، والفن، والمجتمع المدني.
وقد كشفت تسجيلات صوتية سرّبتها منصة The Grayzone من مؤتمر مغلق لـ AIPAC في عام 2025، أن المدير التنفيذي للجنة العمل السياسي الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، إليوت برانت، تفاخر بتأثيره على شخصيات كبرى مثل مدير الـ CIA جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز.
وأكد برانت في التسجيلات أن هذه الشخصيات لطالما دعمت المصالح الإسرائيلية، وأن AIPAC موّلت حملاتهم وساعدتهم على الوصول لمراكز القرار، مما منحها حق الوصول إلى معلومات إستراتيجية.
الخلاصة: القوة الوحيدة القادرة على فرض انسحاب أميركي كامل من سوريا هي الجمهورية التركية عبر ثباتها في مواجهة الإرهاب.
فمنذ عام 2016، تمكّنت تركيا من إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا عبر عمليات عسكرية ضد تنظيم PKK الإرهابي، وأسهمت في تحجيمه، وأقامت علاقات صداقة وتنسيق مع الحكومة السورية.
نعم، الأمر ليس سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا أيضًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وصحفي تركي
الجزيرة
——————————–
=======================
عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 23 نيسان 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
———————————
سورية الجديدة (1)| جوفيات حرب وأصابع إسرائيلية هامشية في السويداء/ شهيرة سلوم
23 ابريل 2025
عند مطلع دارة القنوات، مقرّ الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز حكمت الهجري في جبل العرب، يتقدّم رتلٌ من الأهالي بأزياء مختلطة، بعضها عسكريٌّ. يغرسون في خواصرهم ساريات أعلام بألوان خمسة، ويخبطون الأرض مردّدين “هولا هالي السويدا والربع سلطان، يقحمون الموت دايماً ما يهابوا المنيّة”. يدخلون رهطًا تلو رهط ساحة الدارة قبل أن يشكّلوا دائرة. يتقدّم أحدهم إلى الوسط ويبدأ القفز والدبك بالعلم، يلحق به آخَرٌ فتعلوا الأهازيج أكثر وتختلط الأنفاس مع الكلمات وكأنّها جندٌ في معركة. يتسابق الرجلان في الخبط والدبك، فتدبّ الحماسة في الحشد. تلك “الجوفيّة”، كما يسمّيها الأهالي، التي تُسيَّر عادةً في أوقات الحرب، كانت آتية إلى حكمت الهجري داعمةً ومبايعةً، يستقبلها الشيخ عند باب مضافته، قبل أن يودّعها بعد وقت قصير استعدادًا لرتل لاحق.
أثناء مغادرة الوفد، يتقدّم نحونا رجلٌ بثياب عسكريّة معلنًا أنّهم فصيل شباب شهلا، جاؤوا لإعلان الدعم للشيخ ووضع أنفسهم تحت تصرّفه. على الرغم من الوفود الشعبية، فإنّ شيخ العقل حكمت الهجري الذي يعدّ أعلى مرجعية روحية للطائفة، كان رافضًا الحديث إلى الإعلام خصوصًا بعد التسريبات من داخل أحد مجالسه، التي بيّنت موقفًا حادًا من دمشق. مع هذا استقبلَنا، وأكّد على أنّ الاتصالات مع الإدارة السورية الجديدة لم تنقطع، عبر محافظ السويداء مصطفى بكّور، لكن “الحكومة متعنّتة”. اكتفى بهذا، قبل أن يضيف: “منتظرون الآن، ونحن نستعدّ لسيناريوهات عدّة”، وماذا تنتظر يا شيخنا “التطوّرات الدولية؟”، وأيّ سيناريوهات؟ لا يُجيب، لكنّ حجيج الوفود المترَأسة ببزّة عسكرية إليه، وصيحات الجوفيّات، وما علِمنا به خلال لقاءاتنا مع فصائل عسكرية تُوالي الهجري، قد يشي بواحد من هذه السيناريوهات: “القتال”، وهو ما لم يخفِهِ الشيخ لاحقاً. لا يتحكّم الهجري بالفصائل العسكرية الأساسية في الجبل (رجال الكرامة وأحرار الجبل)، لكن يأتمر بأمره تجمّع من فصائل عدّة، أغلبها شُكّل حديثاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تسلّم حكمت الهجري، الذي تتوارث عائلته المنصب الديني الأرفع في المحافظة منذ القرن التاسع عشر، مشيخة العقل بعد وفاة شقيقه الشيخ أحمد في حادث سير غامض عام 2012. شاكس الأخير نظام الأسد، حين دعا إلى انشقاق الدروز عن الجيش، وعارض تشكيل مليشيا من الطائفة للقتال مع النظام. كما رفض إصدار بيان ضدّ انشقاق أوّل ضابط درزي عن جيش الأسد خلدون زين الدين، الذي شكّل كتيبة سلطان باشا الأطرش، وقُتل في معارك ظهر الجبل في المحافظة (يناير/كانون الثاني 2012) ضدّ قوات النظام. حاول الأسد استرضاء الشيخ أحمد، فلم يفلح. يتناقل أبناء المحافظة بأنّه في تلك المضافة التي استضافنا فيها الشيخ الهجري في القنوات، وعلى بُعد أمتار قليلة من مكان جلوسنا، نام بشار الأسد عميقًا. حينها جاء إلى مضافة الشيخ أحمد، طالبًا أن يرتاح فيها لدقائق، فأُخليت له، وغفا حتى الصباح. كان ذلك في مارس/آذار 2011، بعد اندلاع الثورة السورية. المرّة الثانية التي جاء بها إلى السويداء، كانت بعد خمسة أيام من وفاة الشيخ أحمد بحادث سير غامض يقول البعض إنه كان اغتيالًا.
تسلّم الهجري المشيخة داعمًا للأسد منذ البداية، ولم يتحوّل عنه إلّا في عام 2021، حين أهانه رئيس فرع الأمن العسكري في درعا لؤي العلي. ويعدّ مفتاحًا أساسيًّا في المحافظة، بما يمثله من سلطة دينية وزمنية عليا. توجّهت إليه القيادة الجديدة بعد خلع نظام بشار الأسد، وفتحت معه قنوات اتصال، لكنّ موقفه المعلن كان الأكثر تشددًا تجاه دمشق مقارنة بشيخَي العقل الآخرين؛ حمود الحناوي ويوسف جربوع، وهو ما ترك تأثيرًا واضحًا على شعبيته، ودفعه إلى نوعٍ من الاعتكاف.
أذرع عسكرية انفصالية
مرتديًا بزّة عسكرية، داخل مضافة بيت جبليّ في بلدة شنيرة القريبة من الحدود مع الأردن، يجلس قائد المجلس العسكري في السويداء طارق الشوفي، مقدّمًا فصيله المسلّح المنشَأ حديثًا ذراعًا عسكريةً للهجري. يستهلّ الحديث معنا من انشقاقه عن جيش النظام في عام 2015 حين كان يخدم في محافظة إدلب، وهي رواية يشكّك فيها ناشطون التقيناهم في وقت سابق، متحدّثين عن فرار من الجيش وليس انشقاق. ينتقد الشوفي نظام الأسد، لكن لا يُخفي معارضته لفصائل الثورة، بقوله إنّ الأسد وبعد إطلاقه المساجين المتطرّفين في صيدنايا (2012) “حوّل الثورة إلى إرهاب”.
لا تُعرف انطلاقة واضحة للمجلس، بعد سقوط النظام أو قبله، ويظهر حديث الشوفي عن التأسيس مرتبكًا، يقول إنّ تشكيله بدأ مع بدء حراك السويداء (2023)، ثم يعتبره امتدادًا للمجلس العسكري للجنوب (2016)، والمجلس العسكري الذي كان يقوده العقيد المنشق ربيع حمزة، قبل أن يُشير إلى أنّ الإعلان عن مجلسه حصل “لحظة سقوط النظام، وبعض الفصائل انضمت إلينا بينهم (نشام الجبل)، وبعضها الآخر عارضنا”، وفي مقدّمة المعارضين له، أكبر فصيلين مسلّحين في الجبل: رجال الكرامة وأحرار العرب.
يعود ليضيف “كنّا نعمل في السرّ مع الجيش الحرّ منذ الانشقاق، في درعا والقنيطرة ودير الزور والمنطقة الشرقية”. ماذا عن عناصره وتسليحه؟ جميعهم من الجنود المنشقّين، لم يذكر عددهم. أمّا التسليح فيقول إنّه جاء “بأموالنا وبجهد شخصي، وعند سقوط النظام استولت مجموعاتنا على الأسلحة المتوسطة والخفيفة”، وهنا مربط الفرس لسلاح الفصائل التي تشكّلت متكاثرةً بعد سقوط النظام في الجبل.
واضحةٌ معارضة هذا التشكيل المسلّح للقيادة السورية الجديدة إذ يسمّيها “بسلطة الأمر الواقع”، ويرى أنّ وصول أحمد الشرع إلى السلطة “كان على طريقة الانقلاب العسكري؛ لم يمدّوا أيديهم للضباط المنشقين. حاولوا الاعتماد على الفصائل الموالية لهم”.
في وقت سابق، أثار الشوفي الجدل بردّه على عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلًا “نشكر كلّ من يدعم ويساعد في الدفاع عن الطائفة الدرزية”. يكرّر موقفه هذا أمامنا بقوله “إذا كانت إسرائيل تريد تقديم الحماية، فلا أستطيع منعها. لم أطلب منها أن تحمي الدروز، ولا أستطيع أن أرفض إذا جاءت لحمايتهم. هذا الموقف عند الحكومة”.
وعن طروحات الانفصال، يضيف “لا نريد الانفصال عن سورية، نريد علاقة جيدة مع العاصمة”، معتبرًا أنّ النظام الأمثل لسورية هو الفيدرالي “وهو مطبق فعليًا بدون إعلان”، في إشارة إلى التقسيم الواقعي الذي كان جاريًا خلال فترة الأسد. ينفي التنسيق مع أي جهة خارجية أو الارتباط بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويعلّل ربطهم بها “لتشابه الطروحات”. لا تبدو للرجل أيّ حنكة سياسية؛ ففي انتقاده منفعلاً للإدارة الجديدة، يقول إنّها متطرّفة لأنّها “أقامت علاقات مع أفغانستان”، ومع “تركيا، النظام الإسلامي”، لكن يا رجل “أفغانستان دولة مساحتها أكبر من سورية بأربع مرّات ونظام تركيا ليس إسلاميًا، ماذا تقصد؟” فيتراجع قليلًا، ويقول: “نحن نعمل وفق توجيهات الشيخ حكمت الهجري، وما يقبله نقبله، نحن نملك القرار العسكري، أما القرار السياسي، فبيده”، مع العلم بأنّ الأخير نفى سابقًا دعمه للمجلس.
في المضافة التي التقينا فيها الشوفي صورة لجمال عبد الناصر وكمال جنبلاط وابنه وليد. نسأله عن سبب تعليقها، يردّ أنّها “صورة قديمة تمثل توجّه والدي، ولا تمثلني. الأفكار التي طُرحت لم تعد مناسبة حاليًا”.
يُحكى في المحافظة أنّ عناصر المجلس متورّطون في حادثة رفع العلم الإسرائيلي الشهيرة، وهذا ما ينفيه الشوفي، معتبرًا أنّها “حالة فردية”. وكان شباب من السويداء قد أنزلوا العلم السوري المرفوع وسط دوار العنقود عند مدخل السويداء الشمالي، ورفعوا مكانه العلم الإسرائيلي. لم تمضِ دقائق، حتى هرع آخرون وأنزلوا العلم الإسرائيلي، رافعين مكانه علم طائفة الموحّدين الدروز بألوانه الخمسة؛ الأخضر، والأحمر، والأصفر، والأزرق، والأبيض. حادثة تلقى استهجان كلّ من التقيناهم هنا.
من التيارات التي تتبنّى طروحات انفصالية، وإقامة الإقليم الجنوبي (في درعا والقنيطرة والسويداء) أسوة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية (قسد)، وإقامة السّلام مع إسرائيل؛ حزب اللواء السوري. لم نرصد وجودًا لأنصار هذا الحزب خلال وجودنا في المحافظة، لكن حدثتنا عنه ناشطات شاركن في حراك ساحة الكرامة في أغسطس/آب 2023، قلن إنّه تأسّس بتسهيل من ضابط المخابرات السوري علي مملوك، ومؤسسه ينشط من هولندا ويُدعى مالك أبو الخير. لا يحظى الحزب بشعبية في المحافظة، لكنه يوزّع أموالًا على الناس، ولديه جناح عسكريّ يضمّ بضع مئات المسلحين، ويُعلن ولاءه للشيخ الهجري (بيان أصدره في مارس الماضي). ولا يستبعد البعض تورّط أنصاره أيضًا في حادثة رفع العلم الإسرائيلي.
جربوع: لن نسلّم السّلاح ولن يدخل الغرباء السويداء
في مقام عين الزمان، وسط مدينة السويداء مقرّ شيخ العقل يوسف جربوع، تبرز نواحٍ أخرى من أعمال ناشئة لمشيخة العقل الثالثة في المحافظة. تتوزّع في ساحاته لافتات تشير إلى مكاتب صحّية، وإغاثية، وخيرية، وتعليمية، إضافة إلى “مكتب حلّ النزاعات”، وهو نوع من المحكمة المحليّة أُسّست في ظلّ غياب الدولة لحلّ النزاعات الأهلية.
بدا الشيخ جربوع، الذي عُرف بمعارضته لحراك السويداء وانحيازه لنظام الأسد، مرحّباً بتشكيلة الحكومة الجديدة، مثنيًا خصوصًا على الطريقة الحضارية في إعلان الحكومة والبرنامج الذي قدّمه كلّ وزير أمام الإعلام. وعن التواصل مع دمشق، يشير إلى أنّه يحصل بالحدّ المقبول عبر المحافظ (مصطفى بكور)؛ أمّا عن التجاوب، فهو أيضًا بالنسبة له “بالحدّ المقبول”. يتطرّق إلى العلاقة التي تربطه بوزير الزراعة الجديد، ابن السويداء، أمجد بدر، وينفي أن يكون قد رشّحه، لكنّه يؤكّد على أنّه معارض قديم فصل من عمله سابقًا بسبب مواقفه المعارضة، ومن مؤسّسي ساحة الكرامة (حراك السويداء 2023). بالنسبة لمستقبل سورية ورؤيته لنظام الحكم المحبّذ له، يرى أنّ الصورة حاليًا ضبابية خصوصًا بعد أحداث الساحل والتصرّفات الطائفية؛ فهذا مبعث قلق لدى الطائفة، قبل أن يشير إلى مآخذه على الإعلان الدستوري، قائلًا إنّه لا اعتراض على أن يكون دين الدولة الإسلام أو رئيس الدولة مسلمًا، لكنّ اعتراضه على أن يكون “الفقه الإسلامي مصدرًا أساسيًا للتشريع”، فهذا تعبير فضفاض. يُظهر جربوع خلال حديثه امتعاضًا واضحًا من دمشق “ما نراه اليوم ضبابي يدعو للتخوّف، ننتظر ونراقب”.
بالنسبة لطروحات التقسيم، يؤكّد أنّ ما طُرح من مشاريع التقسيم إبّان الاستعمار الفرنسي “رُفض من أهلنا وعلى رأسهم قائد الثورة سلطان الأطرش؛ نحن جزءٌ من الجغرافيا السورية ومن المكوّن السوري، ولا زلنا متمسكين بهذا الخيار، لأنّه ضمانة للطائفة”. إذًا؛ موقف الشيخ جربوع المُعلَن ضدّ التقسيم؛ ضدّ الدويلات.
عن الملفّ الأمني، يرى أنّ التخلّي الأمني من الدولة بدأ منذ النظام الأسدي، “وخلال فترة الحرب (بعد الثورة)، شُكّلت فصائل مسلّحة، منها تابعة للجهات الأمنية الحكومية (يقصد نظام الأسد)، ومنها أهلية، ما خلق مرجعيات عدّة للفصائل المسلّحة تسبّبت بفوضى أمنية”. منذ سقوط النظام حتى الآن، لا تزال الدولة غائبة، يقول. ويشير جربوع إلى مشروع مطروح لحلّ مشكلة الأمن يتمثل بإنشاء تشكيلات من الأمن العام والجيش، عناصرهم حصرًا من أبناء السويداء ولحماية أمن المحافظة فحسب، أمّا “الإشراف فيكون لحكومة دمشق”، وهذا قد يساعد في مكافحة الفوضى ويعيد هيبة الدولة. لكن ألا يخالف إنشاء ضابطة عدلية مشكّلة “من أبناء محافظة السويداء حصرًا”، مفهوم الدولة المركزية الشاملة ويحلّ التقسيم المناطقي أمنياً؟ يردّ “صحيح لكن لكلّ وقت ظروفه”. هل هناك مشكلة ثقة بين أبناء سورية؟ يرى أنّ ما جرى في منطقة الساحل تحديدًا أضعف الثقة في الحكومة الحالية في إمكانية حفظ الأمن، ويعزّز هذا عامل وجود غير السوريين أو ما يسمّى بالمهاجرين في الجيش السوري “فلا ثقة بهؤلاء الأشخاص في محافظة السويداء خصوصًا، تاريخهم إرهابي”، ليعود إلى ما جرى في الساحل واصفًا إيّاه بأنّه “إبادة دينية وعرقية واضحة”.
ولمعالجة مسألة انعدام الثقة وبهدف عدم إفشال مساعي الدولة، سيحمي السويداءَ أبناؤها، أمّا في مرحلة لاحقة بعد استقرار دولة مدنية “قد يجوز الذهاب إلى غير ذلك”. بالنسبة للتفاهمات مع دمشق، الردّ واضحٌ: “لا نيّة لنا بتسليم السلاح، ولا نقبل دخول الغريب إلى المحافظة”، ويعني بالغريب أبناء غير المحافظة.
يستعيد الشيخ جربوع عَرَضًا الهجوم الذي شنّه تنظيم “داعش” من الناحية الشرقية عام 2018، وهُرِعَ لمواجهته خمسون ألفاً من أبناء المحافظة؛ وهو هجومٌ يستذكره أغلب مَن التقيناهم، للإشارة إلى همّة أبنائهم في ردّ الاعتداءات، دون إغفال أيادي نظام الأسد في تدبيره وفتح الطريق أمامه، عبر نقل عناصر داعش من المخيّمات إلى مشارف المنطقة الشمالية الشرقية. ويقول إنّه كان مقاتلًا في ساحة المعركة حينها إلى جانب الشيخ الحناوي.
يعود جربوع إلى الغمز واللّمز من دمشق، ويرى أنّ الأحوال تحوّلت من سيّئ إلى أسوأ بعد سقوط النظام من الناحية الأمنية والاقتصادية، مع خسارة العديد من الأهالي لوظائفهم بعد فصلهم من العمل ومنهم عناصرُ الجيش المسرّحون. ويتقدّم ملفّا فصل الموظفين؛ أو تعليق عملهم، بحسب ما يؤكّد لنا مسؤول في إدارة الإعلام بموقع آخر من جولتنا، وتسريحُ عناصر النظام السابق، أسباب المشكلة الأمنية في مختلف محافظات سورية، وليس في السويداء فحسب؛ لتتعاظم هذه المشكلة في الساحل السوري؛ الخزّان البشري لمؤسّسات نظام الأسد العسكرية والخدمية.
نتطرّق في الحديث مع الشيخ إلى مسألة التدخل الإسرائيلي، فيشير إلى أنّ زيارة وفد من حضر ضمّ 150 رجل دين وشخصية درزية سورية، إلى مقام النبي شعيب في قرية حطين، دينيةُ الطابع، وكانت قائمة قبل عام 1967، لكن بعد حرب 1973 توقفت، وانقطعت الصلات بين حضر والجولان، إذ تنقسم أحيانًا العائلة الواحدة بين مناطق سوريّة وثانية محتلّة. ويؤكّد أنّ صاحب المبادرة هو شيخ عقل دروز فلسطين موفق الطريف (المعروف بعلاقته الوطيدة مع الحكومة الإسرائيلية) لإعادة التواصل بين المنطقتَين. أمّا بالنسبة لعرض إسرائيل تقديم الحماية للدروز، فاعتبر أنّ هدفه سياسيٌّ “لإبعاد محافظة السويداء عن تاريخنا العربي والوطني، نحن لم نطلب الحماية من إسرائيل ولا نعلم أن أحدًا منا طلب ذلك”. وعن التواصل مع شيخ العقل في فلسطين، “فهذا طبيعي موجود وقائم قديمًا”، قد يكون بأوقات متباعدة لكنّه قائم “تواصل أهل بأهل، ولا يجري بحث أيّ موضوع سياسي خلال التواصل”. ويشير إلى أنّ أبناء المحافظة موزّعون أساسًا بين أربع دول (يقصد لبنان وسورية وفلسطين والأردن)، لكلٍّ خصوصيتها، “ولا تدخّل لأيّ منها في شأن غيرها”.
تقارير عربية
سورية تُزيح خمسة عقود من الرعب (4): النزع الأخير للوحش
ليست المرّة الأولى التي تتدخل إسرائيل في شأن الموحّدين الدروز في سورية، فحين شنّ الرئيس السوري أديب الشيشكلي حملة على أهل الجبل عام 1954، واعتقل ابن سلطان الأطرش وقمع التظاهرات بالرصاص الحيّ، وجدت الفرصة سانحة لتقديم نفسها حاميةً لأهل جبل حوران، مهدّدة بالتدخل. وفي سنوات الثورة السورية، أعلنت عن مواقف مماثلة على فترات متباعدة، وصلت إلى حدّ المطالبة بإنشاء منطقة عازلة لأتباع الطائفة السوريين في الجولان المحتلّ، بعد هجوم على أبنائها في جبل السماق في إدلب (شنّته جبهة النصرة عام 2015). وكان شيخ عقل الطائفة في فلسطين موفق طريف، قد جمع مساعدات لشراء السلاح لأبناء السويداء بعد هجمات ضدّهم بين عامي 2013 و2015، كما يواظب على لقاء المسؤولين الإسرائيليين، طالبًا حماية أتباع الطائفة السوريين.
********
“يا بني وطني: ليس لكم على اختلاف المذاهب والفئات إلّا عدوٌّ واحد هو الاستعمار”
سلطان باشا الأطرش، من بلاغ الثورة عام 1925
العربي الجديد
——————————————
نتنياهو في المصيدة السورية/ عامر عبد المنعم
22/4/2025
وقع نتنياهو في المصيدة السورية، ولن يخرج منها منتصرا، وإن لم يبادر ويخرج بسرعة من الفخ الذي أوقع نفسه فيه، ويبحث له عن طريق للهروب يحفظ له ماء الوجه سيكون في موقف لا يحسد عليه، ولن يخرج منه سالما، حيث ستغلق عليه كل الأبواب، ليواجه مصيره في أسوأ الجبهات التي فتحها بحثا عن انتصار بعد الهزيمة في غزة، وظن أنه يُنسي بها الإسرائيليين فشله وعجزه عن تحقيق أي إنجاز في القطاع الفلسطيني المحاصر من كل الجهات.
لم يتحمل الإسرائيليون سقوط بشار الأسد الذي لم يطلق رصاصة على الاحتلال، ودفعهم الغيظ والغضب للهجوم على سوريا منذ الليلة الأولى لتغيير النظام، مستغلين حالة الانتقال السياسي وضعف القدرة العسكرية للحكم الجديد، وبروز النزعة الانفصالية للطوائف المتمردة، ووجود الاحتلال الأمريكي في أكثر من 40% من الأراضي السورية، وغياب نصف الشعب السوري مهجرين بالخارج والربع نازحين في الداخل.
لم يعلن الإسرائيليون هدفا محددا من وراء التوغل واحتلال مناطق واسعة في جنوب غرب سوريا والوصول إلى جبل الشيخ، واستمروا في القصف الجوي منذ أكثر من 3 أشهر للمطارات والمعسكرات والمواقع الاستراتيجية، فتارة يقولون إنهم يوسعون منطقة أمنية منزوعة السلاح لحماية المستوطنات في الجولان، وتارة أخرى يزعمون أنهم يحمون الأقليات، وفي بعض الأحيان يقولون أنهم يخشون من هجوم جماعات سورية مسلحة، ومؤخرا أعلنوا رفضهم لوجود حكم إسلامي سني على حدودهم!
رعب طوفان الأقصى
لا يستطيع الإسرائيليون نسيان ما جرى في طوفان الأقصى وهجوم جنود القسام بأسلحتهم الخفيفة على فرقة غزة وهزيمتها، وأسر قادتها وجنودها، رغم التفوق العسكري الإسرائيلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وكل الترتيبات العسكرية التي تضمن الأمن للكيان، ويدفعهم الرعب من تكرار الهجوم البري إلى استمرار الحرب وتدمير القطاع، طمعا في استسلام حماس ورفع الراية البيضاء، ويفتحون جبهات أخرى في معارك لا نهائية غير مبالين بالعواقف.
الخوف من تكرار الهجوم أصاب نتنياهو ومعاونيه بالهلع وفقدان العقل والاتزان، وبدلا من وقف العدوان على غزة والبحث عن هدنة طويلة والاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهي أقصر الطرق لاستعادة الأمن والهدوء؛ فتح الإسرائيليون جبهات خارجية واندفعوا في حروب عدوانية بدعاوى ” القضاء على التهديد” وهو هدف مستحيل، وقرروا التأسيس لسياسة دفاعية جديدة تنتقل من الدفاع إلى الهجوم الاستباقي، لا تكتفي بتقوية الدفاعات داخل حدود الكيان، وإنما بالتوسع العسكري خارجه، أي العمل العسكري الدائم داخل غزة وفي دول الجوار.
منظومة الدفاع البري متعدد الطبقات
أعلن نتنياهو عن المنظومة الجديدة للدفاع البري متعدد الطبقات، وتناولها القادة العسكريون بالشرح في الإعلام الإسرائيلي، لإقناع الرأي العام بضرورتها الاستراتيجية لإنقاذ دولة الاحتلال من الزوال، وتتكون المنظومة من ثلاث طبقات، الأولى: داخل الأراضي الإسرائيلية حيث يتم تطوير الخطط الحالية وسد الثغرات التي كانت سببا في اجتياح الغلاف، والطبقة الثانية: داخل أرض العدو (غزة ولبنان وسوريا) حيث تنتشر القوات الإسرائيلية في منطقة فاصلة، يختلف عمقها حسب الطبيعة الجغرافية والعملياتية، ويتراوح الانتشار بين الوجود الدائم في نقاط استراتيجية أو من خلال دوريات برية، ومراقبة جوية دائمة بالمسيرات، والطائرات المقاتلة التي يمكنها قصف أي هدف أيا كان وفي أي وقت، والطبقة الثالثة: نزع السلاح من المناطق والدول المجاورة التي تشكل تهديدا لـ “إسرائيل”.
خطط نتنياهو للدفاع متعدد الطبقات تنقل الصراع العربي الصهيوني إلى مرحلة بالغة الخطورة، فهي لا تحترم سيادة الدول، وتعطي الإسرائيليين سلطات مطلقة في العدوان وتوجيه الضربات بلا حساب، وهي اعتداء صريح على القانون الدولي، الذي لا يعطي أي دولة مشروعية احتلال أرض الغير، والعدوان على الجيران بمزاعم منع التهديد.
إذا تم تمرير السلوك الإجرامي والقبول بحق الإسرائيليين في تنفيذ خططهم العدوانية في غزة ولبنان وسوريا، فما الذي يمنعهم من العدوان غدا على مصر والأردن وأي دولة عربية أو إسلامية إذا شعر الكيان وداعموه بالخوف والريبة؟!
العدوان على سوريا مغامرة خاسرة
إذا كان الإسرائيليون قد نجحوا في تقييد حزب الله – ولو بشكل مؤقت-، لكونه جماعة داخل دولة، من خلال الضغط على الحكومة والجيش اللبناني واستغلال الوضع الداخلي المعقد، فإن تنفيذ الخطة الإسرائيلية في سوريا له تداعيات أكبر مما يتوهمه صانع القرار الإسرائيلي، فالصراع هنا مع دولة، تحظى بالتعاطف من طيف واسع من دول عربية وإسلامية وحتى أوربية لأهمية سوريا ولأسباب سياسية ومصلحية.
قد تكون الحكومة السورية الجديدة ضعيفة عسكريا لكن قوتها في شعبها الذي خاض حرب تحرير طويلة وقاسية، وتحمل القصف الجوي بالبراميل والصواريخ، وقاوم الغارات الروسية من الجو وتصدي للاحتلال الإيراني وقواته البرية حتى نجح في النهاية في تحقيق الانتصار، ورغم حرص الرئيس السوري أحمد الشرع على تجنب المواجهة الآن قبل إعادة بناء الدولة المدمرة وعودة الشعب المهجر؛ فإن استمرار العدوان الإسرائيلي قد يفرض على السوريين القتال مكرهين.
لا يحتاج السوريون إلى الدبابات والطائرات القديمة التي دمرها الإسرائيليون، ويكفيهم العنصر البشري الاستشهادي –بالملايين- الذين يمكنهم في أي لحظة تنفيذ هجوم مماثل لطوفان الأقصى على قوات الاحتلال المتوغلة في الأراضي السورية وسحقها، ويمتلك السوريون الطائرات المسيرة والصواريخ التي تمكنهم من فرض معادلة جديدة تردع الاحتلال، وتجبر نتنياهو إلى العودة إلى اتفاقية فك الإشتباك الموقعة عام 1974 التي أعلن الشرع أنه ملتزم بها.
لقد ذاق الإسرائيليون الرعب في معركة رمزية في درعا، عندما توغلوا في مدينة نوى بالدبابات، فخرج عليهم الشباب السوري والمقاومة الشعبية بأسلحة خفيفة واشتبكوا مع الإسرائيليين، ونشر الإعلام الصهيوني -وقتها- عن سقوط قتلى وجرحى من جنودهم، وتم إنهاء المعركة بدخول المسيرات والقصف المدفعي واستخدمت المروحيات لفتح طريق للانسحاب.
قد يهدد نتنياهو بضرب مقار الحكم وتدمير الدولة، لكنه سيكون ارتكب خطأ عمره، وسيفتح على نفسه معركة كبرى، فالجولاني وأفراد حكومته سيرتدون ملابس الحرب ويخوضون معركة وجود لن تكون أصعب من مواجهة جيوش بشار والدول التي كانت معه، وسيواجه الإسرائيليون جبهة واسعة يصعب حصارها، حتى لو تورط معه الأمريكيون بشكل مباشر، وخلف سوريا تركيا وخلفهما العالم الإسلامي الذي سيجدها فرصة للانتقام لغزة، التي لا يستطيع المسلمون الوصول إليها ونصرتها.
ستكون المواجهة مع تركيا
يعلم الإسرائيليون أن تركيا تقف مع السوريين بكل قوتها، وترفض الأطماع الإسرائيلية في سوريا لأسباب استراتيجية وعقدية، وإذا ما قرر نتنياهو مواصلة العدوان فإنه يقترب من الصدام مع الأتراك، الذين سيمدون السوريين بالأسلحة المتطورة القادرة على تهديد الكيان الصهيوني، وخشية هذا السيناريو الكارثي على الإسرائيليين تدخل ترامب، الذي طلب من نتنياهو في زيارته الأخيرة لواشنطن عدم إغضاب أردوغان والبحث عن تجنب الصدام.
في البداية شجعت المواقف العنترية لترامب نتنياهو للتفكير في الدخول في حرب مع الأتراك وبدأ يناقش خطط المواجهة المحتملة، لكن العجز الإسرائيلي والأمريكي في غزة حتى الآن أمام الصمود الفلسطيني الأسطوري، والفشل في ردع الحوثيين في البحر الأحمر من الدوافع التي أجبرت ترامب على التراجع والتعقل وتهدئة الجبهات، خاصة بعد غرق الرئيس الأمريكي في الأزمات الداخلية بعد قرارات الرسوم الجمركية التي هزت مكانة الولايات المتحدة، ووضعها في مواجهة مع الصين وأوربا وباقي دول العالم.
الحكومة السورية الجديدة تسير بخطى محسوبة، وقد نجحت في توحيد الدولة والقضاء على خطط التقسيم، وأفشلت النزعات الانفصالية للطوائف، وبالتأكيد لديها خطط كاملة بالاتفاق مع الأتراك لمواجهة العدوان الإسرائيلي، ولن يكون أمام نتنياهو غير التوقف عن العدوان والانسحاب، وإن لم يتم الخروج الإسرائيلي من سوريا طواعية فسيكون بالإكراه.
المصدر : الجزيرة مباشر
صحفي وكاتب مصري، شغل موقع مساعد رئيس تحرير جريدة الشعب، ورئيس تحرير الشعب الالكترونية.
———————————
تركيا وإسرائيل.. الصراع بين التحمل أو الحرب!/ فخري شاهين
22/4/2025
تعيش إسرائيل حالة من الارتياح بسبب الدعم الذي يوفره لها النظام العالمي، والذي أعطاها مساحة واسعة للتصرف، مما جعلها تتصرف بثقة مفرطة.
فقد بدأت إسرائيل تتوهم أنه يمكنها فعل أي شيء تريده دون التفكير في العواقب أو إمكانية معاقبتها، وذلك لأنها زرعت الخوف في الدول المجاورة لها، لكن هذا الوهم -ككل الأوهام- منفصل تمامًا عن الواقع.
وشهد العالم في الفترة الأخيرة التهور الإسرائيلي في الهجمات التي شنتها داخل الأراضي السورية، والتي كانت تحمل رسائل واضحة لتركيا.
وقد يتساءل بعضنا: كيف يمكن أن تكون ضربة في سوريا موجَّهة إلى تركيا؟ أو ما علاقة ما يحدث في سوريا بتركيا من الأساس؟
الجواب بسيط: لم تعد الملفات الإقليمية معزولة فيما بينها، فكل ما يحدث -أو قد يحدث- في سوريا أو ليبيا أو البلقان أو قره باغ أو قبرص أو حتى في القرن الإفريقي، بات يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي التركي.
وبرأيي، فإن تجاهل إسرائيل هذه الحقيقة هو السبب الجوهري في سوء تقديرها السياسي في سوريا.
وبغضّ النظر عما يقال، فهناك بعض الحقائق الجديدة في سوريا:
الحقيقة الأولى: سوريا باتت تحت إدارة جديدة.
الحقيقة الثانية: هذه الإدارة تتصرف بوعي وثقة، وتتحرك وفق خطة لا بردود أفعال.
الحقيقة الثالثة: كل قوة وكل مكسب تحققه الدولة السورية يُعَد خسارة مباشرة لإسرائيل.
من الواضح أن إسرائيل تدرك فقط الحقيقة الأخيرة، أي أن كل تقدُّم تحققه سوريا سيكون ضدها. لكن الأهم من ذلك، هو أن إسرائيل قد تغافلت عن الحقيقة الثانية، التي تكمن في القوة العقلانية الجديدة التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة.
فالحكومة الجديدة في سوريا تتصرف بوعي، وستتحرك بشكل عقلاني وعلى خطى هادئة. ولذلك، يمكننا القول إن أي مجتمع ينجح في أن يصبح دولة، سيحقق النصر في النهاية، عاجلًا أم آجلًا.
لكن النصر لم يعد يعني سوريا فقط، بل أصبح يشمل دولًا أخرى في المنطقة، وعلى رأسها تركيا.
لم تعد تركيا مجرد موضوع نقاش على طاولات الآخرين، فقد ازداد نفوذها بفضل الزخم والإنجازات العسكرية التي حققتها في ربع القرن الأخير، إذ أصبحت لاعبًا أساسيًّا في منطقة الشرق الأوسط، ولم يعد قرارها يخضع للتأثيرات الخارجية.
وأوضح مثال على ذلك هو فشل إسرائيل في انتزاع دعم أمريكي صريح ضد تركيا، مما اضطرها إلى العودة خالية الوفاض، وهو ما يعكس أن القرار بشأن تركيا أصبح حصريًّا بيد أنقرة، ولا يحق لأحد التدخل فيه.
السياسة الخارجية التركية
عند النظر إلى السياسة الخارجية التركية منذ نشوء الجمهورية، نلاحظ أنها مرت بمرحلتين أساسيتين تكمل إحداهما الأخرى.
المرحلة الأولى كانت تحت قيادة مصطفى كمال أتاتورك، الذي صاغ سياسة “سلام في الداخل. سلام في العالم”، وهي سياسة تعتمد على الحياد والتركيز على الأمن الداخلي وتجنُّب المواجهات المباشرة.
تلك السياسة بقيت تشكل العقيدة الأساسية لتركيا حتى وقت قريب، على الرغم من بعض الاستثناءات مثل تدخلها في قبرص عام 1974. ولكن مع مرور الزمن، وتحديدًا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بدأ التحول.
في السنوات الأخيرة، بدأت المرحلة الثانية، وبدأنا نرى تحولًا حقيقيًّا في السياسة التركية. فمع صعود الرئيس رجب طيب أردوغان، جرى تبنّي مبدأ جديد “عالم أكثر عدلًا ممكن”.
وهذا الشعار يعكس تغيرًا كبيرًا في الاستراتيجية التركية، إذ أصبحت تركيا تسعى إلى أن تكون فاعلة، وأن تضع بصمتها في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.
ما تحاول إسرائيل فعله اليوم هو دفع الدولة والأمة التركية إلى الانخراط في معركة قبل أوانها في سوريا، لكن الحقيقة التي تغفل عنها إسرائيل هي أن “عقل الدولة” التركي قد حدد توقيت هذه المعركة سلفًا، وبدأ الاستعداد لها منذ وقت طويل.
فكل خطوة تتخذها تركيا وكل مشروع تطلقه، سواء أكان في سوريا أم في أي مكان آخر، هو جزء من هذا الاستعداد المتواصل.
إحدى الحقائق التي يجب وضعها في الحسبان هي أن “التحمل” لم يكن يومًا مجرد ضعف أو انتظار، بل كان جزءًا من التحضير للمرحلة القادمة.
أما الآن، فلم تعد عبارة “إما التحمل أو الحرب” ملائمة، لأن الاستعداد للحرب قد بدأ فعلًا، والتحمل أصبح جزءًا من الاستعداد للعملية الكبرى، ولا مجال الآن للانتظار.
وبالنسبة للنصر فإنه ليس الهدف الأساسي في هذه اللحظة، فالقضية لا تكمن في بلوغ النهاية، بل في خوض المعركة.
سياسي تركي
الجزيرة
——————————-
صحيفة: قلق أميركي من خطط تركية لنقل منظومة S-400 إلى سوريا
2025.04.22
قالت صحيفة “Ekathimerini” اليونانية إن التحذيرات في الأوساط السياسية الأميركية تصاعدت بعد ورود تقارير تفيد بأن مسؤولين أميركيين ناقشوا مقترحاً تركياً يقضي بنقل منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع “S-400” من الأراضي التركية إلى سوريا، ما أثار قلقاً بالغاً لدى عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم عدم وجود قرار رسمي بشأن هذا المقترح حتى الآن، فإن طرحه ضمن نقاشات دبلوماسية أثار موجة انتقادات في واشنطن، لما له من تداعيات خطيرة على أمن الحلفاء، وعلى رأسهم إسرائيل، وعلى صدقية العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى وزارة الخارجية الأميركية، أعرب النائبان الجمهوري غوس بيليراكس والديمقراطي براد شنايدر بحسب ما ورد في صحيفة “Ekathimerini” اليونانية، عن رفضهما الشديد للفكرة، محذّرَين من أن تنفيذ هذا المقترح سيُشكل “تصعيداً خطيراً”، مؤكدَين أن “المنظومة ستُغيّر المشهد الدفاعي الإقليمي في حال نشرها على الأراضي السورية، خاصة في الممر الغربي للبلاد”.
تأثير استراتيجي وأمني واسع
وأكد النائبان أن منظومة S-400، التي يصل مداها إلى 400 كيلومتر وتملك قدرة متقدمة على رصد الأهداف الشبحية واعتراض الصواريخ، ستحدّ بشكل كبير من قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربات جوية ضد الأهداف الإيرانية أو قوافل الأسلحة المتجهة إلى “حزب الله”.
وأضافا: “بغض النظر عن الجهة التي ستتولى تشغيل النظام – تركيا أو جهة حليفة للنظام السوري – فإن النتيجة واحدة: المزيد من التعقيد الأمني في منطقة تشهد توترات متصاعدة، وإذا بقيت السيطرة بيد أنقرة، فإن خطر المواجهة المباشرة مع إسرائيل سيصبح احتمالًا واقعياً.
رفض تخفيف العقوبات
وأوضح النواب أن محاولة تبرير هذا النقل كوسيلة لتخفيف العقوبات المفروضة على أنقرة بموجب قانون “مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات” (CAATSA) هو تفسير مضلل، مؤكدين أن العقوبات فُرِضت بسبب حصول تركيا على المنظومة من روسيا، وليس بسبب مكان وجودها.
وقالَا في الرسالة: “نقل المنظومة إلى سوريا لا يُلغي الانتهاك بل يُغيّر موقعه فقط، والتساهل في هذا الملف سيقوّض صدقيّة قانون العقوبات الأميركي، ويُشجع على التمادي في خرق السياسات الاستراتيجية للولايات المتحدة”.
دعوة لإحاطة سرية
كما طالب النائبان بعقد إحاطة سرية مع الكونغرس لتقييم التداعيات الأمنية والاستراتيجية المحتملة في حال نُفذت خطة نقل منظومة S-400، داعيَين مكتب الشؤون السياسية-العسكرية في وزارة الخارجية إلى إجراء تقييم شامل لتأثير ذلك على “التفوق العسكري النوعي لإسرائيل” والوجود الأميركي في سوريا.
————————–
الشرق الأوسط على المقاس الإسرائيلي!/ محمد عايش
21 – أبريل – 2025
الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على سوريا ولبنان، تؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتغيير شامل للمنطقة بأكملها، وأن لديها مشروعا للتوسع يتضح بشكل أكبر يومياً، حيث تريد إسرائيل خلق مناطق نفوذ واسعة لها في المنطقة برمتها، وهو ما يعني بالضرورة انتهاك سيادة الدول المجاورة والاعتداء على وجودها.
أبرز ملامح التوسع الإسرائيلي في المنطقة تجلى في المعلومات التي كشفتها جريدة «معاريف» الإسرائيلية، التي قالت إن الطيران الإسرائيلي رفض منح الإذن لطائرة أردنية كانت تقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو العاصمة السورية دمشق، واضطر الرئيس عباس للسفر براً من الأردن إلى سوريا، للقاء الرئيس أحمد الشرع، كما أن الصحيفة كشفت بذلك أيضا، أن القوات الإسرائيلية هي التي تسيطر على المجال الجوي لسوريا وتتحكم به. وفي التقرير العبري ذاته تكشف الصحيفة، أن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت تقليص وجودها العسكري على الأراضي السورية، وهو ما يعني على الأغلب والأرجح أنه انسحاب أمريكي لصالح الوجود الإسرائيلي الذي بات واضحاً في جملة من المناطق السورية.
إسرائيل استغلت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وتوغلت فوراً داخل الأراضي السورية، كما قامت بتدمير ترسانة الأسلحة السورية، وسبق تلك الضربات الكبيرة التي تعرض لها حزب الله اللبناني، وما يزال، والتي تبين أن لا علاقة لها بمعركة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث اعترفت أجهزة الأمن الإسرائيلية، بأن عمليتي «البيجر» و»الوكي توكي» كان يجري الإعداد لهما منذ سنوات، وإن التنفيذ تم عندما اكتملت الإعدادات، وهو ما يعني أن الضربة التي تلقاها حزب الله كانت ستحصل لا محالة، سواء شارك في الحرب، أم لم يُشارك، حيث كان يتم التخطيط لها إسرائيلياً منذ سنوات. هذه المعلومات تؤكد أنَّ إسرائيل لديها مشروع للتوسع والهيمنة في المنطقة، وأنَّ هذا المشروع يجري العمل عليه منذ سنوات، ولا علاقة له بالحرب الحالية على قطاع غزة، بل إن أغلب الظن أن هذه الحرب كانت ستحصل لا محالة في إطار مشروع التوسع الاسرائيلي في المنطقة.
الهيمنة الإسرائيلية على أجواء سوريا، والاعتداءات اليومية على لبنان واليمن ومواقع أخرى، يُضاف إلى ذلك القرار الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، وعمليات التهويد المستمرة في القدس المحتلة، إلى جانب تجميد أي اتصالات سياسية مع السلطة، من أجل استئناف المفاوضات للحل النهائي.. كل هذا يؤكد أن المنطقة برمتها تتشكل من جديد، وأن إسرائيل تحاول أن تُشكل هذه المنطقة لصالحها، وتريد أن تقفز على الشعب الفلسطيني ولا تعتبر بوجوده.
خلاصة هذا المشهد، أن إسرائيل تقوم باستهداف المنطقة بأكملها، وتقوم بتغييرها، وتقوم بتدوير المنطقة لصالحها، وهذا يُشكل تهديداً مباشراً واستراتيجياً لدول المنطقة كافة، بما في ذلك الدول التي ترتبط باتفاقات سلام مع إسرائيل، خاصة الأردن ومصر اللذين يواجهان التهديد الأكبر من هذا المشروع الإسرائيلي الذي يريد تهجير ملايين الفلسطينيين على حساب دول الجوار، كما أن دول التطبيع ليست بمنأى هي الأخرى عن التهديد الاسرائيلي الذي تواجهه المنطقة.
اللافت في ظل هذا التهديد أن العربَ صامتون يتفرجون، من دون أن يحركوا ساكناً، إذ حتى جامعة الدول العربية التي يُفترض أنها مؤسسة العمل العربي المشترك لا تزال خارج التغطية، ولا أثر لها أو وجود، كما أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لم تتحرك، ولا يبدو أن لها أي جهود في المنظمة الأممية من أجل مواجهة هذا التهديد الإسرائيلي.
كاتب فلسطيني
القدس العربي
————————-
إعادة تموضع أميركية في سوريا | واشنطن تغري دمشق: الانسحاب مقابل التطبيع
بدأت الولايات المتحدة خطة لتنفيذ انسحاب جزئي من سوريا على ثلاث مراحل، في انتظار تقييم جديد خلال 60 يوماً، يُحتمل أن ينتهي بالإبقاء على نحو 500 جندي أميركي فقط في الداخل السوري وعدد محدود من القواعد في سوريا، في خطة تهدف إلى تلبية رغبة الرئيس دونالد ترامب في تخفيض التدخل العسكري في الدول الأجنبية. ويأتي هذا في ظلّ تسارع التحولات الإقليمية، وسعي واشنطن لتمرير عرض سياسي – أمني متكامل إلى دمشق، عنوانه الظاهر تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، فيما مضمونه الحقيقي استدراج السلطة الجديدة نحو التموضع في المحور الأميركي، على قاعدة التطبيع مع إسرائيل والعداء الكامل لإيران.
وبالفعل، بدأت الولايات المتحدة انسحاباً جزئياً من خلال إخلاء شبه كامل لأكبر قاعدتين في سوريا، هما: «القرية الخضراء»، المعروفة بـ«العمر» في ريف دير الزور الشرقي، و«الفرات» والمعروفة بـ«معمل غاز كونيكو» في ريف دير الزور الشمالي، بالإضافة إلى قاعدة ثالثة بالقرب من بلدة الباغوز على الحدود السورية العراقية، علماً أن الجنود المتواجدين في تلك القواعد انسحبوا في مسارين: الأول في اتجاه «الشدادي» لتعزيزها، والآخر في اتجاه القواعد الأميركية في كردستان العراق، حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين بارزين. وأوضح المسؤولون أنه «بهذا التحرك، انخفض عدد أفراد الجيش الأميركي من 2000 جندي إلى 1400 جندي». وأضاف هؤلاء أن «القادة العسكريين سيعيدون تقييم الوضع بعد 60 يوماً (…) وسيوصون ببقاء ما لا يقل عن 500 جندي في المنطقة لاحقاً».
بدورها، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بياناً أعلنت فيه أنه «سيتم تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر القادمة»، في خطوة وصفتها بأنها «عملية مدروسة ومشروطة». كما أعلن المتحدّث الرسمي الرئيسي للوزارة، شون بارنيل، عن «توحيد القوات في سوريا تحت قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، في مواقع مختارة». ورأى أن هذا الإجراء «يعكس الخطوات الكبيرة التي قطعناها نحو تقليص جاذبية «داعش» وقدراته التشغيلية إقليمياً وعالمياً».
ويأتي ذلك فيما يبدو أن الأميركيين يواصلون سعيهم لاستمالة الإدارة السورية الجديدة، واستثمار سيطرتها على العاصمة دمشق، لإنهاء وجود حركات المقاومة الفلسطينية هناك، بالإضافة إلى دفع التطبيع مع إسرائيل، وتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» على لائحة الإرهاب، وفقاً لوثيقة مسرّبة لقائمة من المطالب الأميركية من سوريا، مقابل إمكانية رفع العقوبات عن الأخيرة بشكل تدريجي.
ويُحتمل، هنا، أن تكون واشنطن قد نفّذت هذا الانسحاب الجزئي لتأكيد جدية احتمال تسليم دمشق آبار النفط أيضاً، مقابل ضمان قيام نظام سياسي صديق لأميركا وإسرائيل، وخصوصاً أن القاعدتين اللتين تم الانسحاب منهما تقعان في أغزر مناطق انتشار النفط والغاز. كما أن توحيدها القوات العاملة في سوريا تحت لواء عملية «العزم الصلب»، يستبطن رسالة باستعدادها لحماية إدارة الرئيس السوري في الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، من هجمات «داعش» – بعد إعلان الأخير الحرب على دمشق -، وأنها تريد منه التعاون لإنهاء نشاط التنظيم في سوريا ومنع استغلاله للأوضاع الأمنية للعودة من جديد.
ومع ذلك، لم ينعكس الانسحاب الأميركي هدوءاً تاماً على الأرض؛ إذ نفّذت قوات أميركية، برفقة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، جولات على سرير نهر الفرات في دير الزور، وفي بلدة تل تمر في ريف الحسكة، توازياً مع إجراء تدريبات ونقل أسلحة في عدة «قواعد» في ريف الحسكة، وتنفيذ حملة أمنية في مخيم الهول ضد خلايا تنظيم «داعش». وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ خطة لإعادة انتشار في سوريا، كانت مُعدّة حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض» موضحة أن «الخطة تقوم على انسحاب من قواعد ودمج أخرى، وتقليص عدد الجنود الأميركيين من ألفين إلى 500 جندي فقط»، علماً أنه قبل سقوط نظام الأسد بأشهر، رفعت واشنطن عدد جنودها من 900 إلى ألفين.
وتضيف المصادر نفسها أن واشنطن «ستحتفظ بثلاث قواعد رئيسية، هي: قسرك في ريف الحسكة الشمالي الغربي، والشدادي في جنوب الحسكة، مع إنشاء قاعدة جديدة في سد تشرين بريف حلب الشمالي الشرقي»، مرجّحة أن «تركّز في وجودها على استمرار مراقبة أمن مخيمات وسجون تنظيم داعش في مناطق سيطرة قسد في سوريا». وتتوقّع أن «تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 500 جندي، إلى حين استكمال دمج «قسد» في بنية الدولة السورية الجديدة بما يتيح استكمال العمليات ضد تنظيم داعش»، معتبرة أن «هذه القواعد ستبقى أيضاً نقطة ضغط متواصلة على دمشق لدفعها إلى الانخراط في المحور الأميركي، وعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل».
———————————
هل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟/ نديم شنر
22/4/2025
في مقالي السابق على الجزيرة نت تحدّثت عن تقاطع المصالح بين إسرائيل وتركيا في الملفّ السوري، متناولًا السيناريوهات السيئة المحتملة، فقلت: “لم تُغيّر إسرائيل من إستراتيجيتها باستخدام نفوذها على الإدارة الأميركية، أو استخدام فرع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا، كأداة لتنفيذ سياساتها.
أما الشرور التي قد تقدم عليها فهي واضحة: تنفيذ عمليات تخريب واغتيالات بغرض تغيير الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع في سوريا، وافتعال أعمال استفزازية باستخدام تنظيم PKK الذي يُتوقع أن يعلن حله قريبًا. فكل شيء قد يتغير، إلا إسرائيل التي تدين بوجودها للاحتلال والإبادة؛ فهي لا تتغير”.
لم أكن أتوقع أن تتحقق توقعاتي بهذه السرعة، لكن الحقيقة أنه لا حاجة لأن تكون “منجمًا” لتتوقع أفعال إسرائيل، فمجرد مراقبتها يكفي.
وهكذا، كما توقعت، أقدمت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي على استفزاز جديد.
نُشرَ أول الأخبار عن ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث أفاد موقع “Ynet” أن مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بنيّة الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا تدريجيًا خلال شهرين.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الإسرائيلية لمنع هذا الانسحاب من خلال ضغط دبلوماسي على واشنطن، فإن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها.
وبحسب التقرير، فإن الأوساط الأمنية في إسرائيل ما زالت تواصل ضغوطها على الإدارة الأميركية.
لاحقًا، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” خبرًا يؤكد أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية انسحاب تدريجي من سوريا. وبموجب هذا القرار، سيتم تخفيض عدد الجنود الأميركيين في سوريا من حوالي 2000 جندي إلى 1400، وستُغلق ثلاث قواعد عسكرية من أصل ثمانٍ.
ومن المقرر إجراء تقييم لاحقًا بشأن إمكانية سحب المزيد من الجنود. ومع ذلك، أوصى مسؤولو البنتاغون بالإبقاء على ما لا يقل عن 500 جندي في سوريا.
وفي خضم هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 18 أبريل/ نيسان بيانًا غير اعتيادي حذرت فيه من احتمال وقوع هجوم في العاصمة السورية دمشق.
وأشارت الوزارة إلى معلومات استخبارية موثوقة عن احتمال وقوع هجمات في أي وقت، حتى في أماكن يزورها السياح بشكل متكرر.
وتوقَّعت الوزارةُ أن تشمل الهجمات فعاليات عامة، فنادق، أندية، مطاعم، أماكن عبادة، مدارس، حدائق، مراكز تسوق، أنظمة نقل عام، وأماكن مكتظة، وقد تقع هذه الهجمات دون سابق إنذار.
بطبيعة الحال، تبادر إلى أذهان الكثيرين أن إسرائيل قد تكون وراء هذه الهجمات المحتملة.
ومن الواضح أن هذه التهديدات تأتي في سياق محاولة إسرائيلية استفزازية لعرقلة انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. فهذه الرسائل، التي تستهدف دمشق، موجهة في الوقت ذاته إلى تركيا، وكذلك إلى الرئيس الأميركي ترامب، الذي لم يستجب لمطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
فحكومة نتنياهو ترى في مثل هذا الهجوم فرصة لجرّ تركيا إلى صراع من شأنه أن يوقف قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، ولذلك أعدّت هذا الاستفزاز بعناية.
فالرئيس الأميركي ترامب كان قد صدم نتنياهو بموقفه من السياسة السورية بقوله: “لديّ علاقة رائعة مع رجل يُدعى أردوغان. هل سمعتم بهذا الاسم؟ أنا أحبه، وهو يحبني. أعلم أن الصحافة ستغضب مني، سيقولون: “ترامب يحب أردوغان!” لكنني أحبه، وهو يحبني. لم نواجه أي مشكلات من قبل. عشنا تجارب كثيرة، لكن لم تحدث بيننا مشكلات. وأتذكر أننا استعدنا القس الأميركي من تركيا في ذلك الوقت، وكانت خطوة كبيرة.
قلت لرئيس الوزراء (نتنياهو): “بيبي”، إن كانت لديك مشكلة مع تركيا فأعتقد أن بإمكاني حلّها. لديّ علاقة ممتازة جدًا مع تركيا ومع زعيمها. أظن أننا نستطيع حل الأمور معًا”.
ونقل ترامب أيضًا حوارًا دار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال: “هنّأته وقلت له إنه فعل ما لم يفعله أحد منذ ألفي عام. لقد أخذت سوريا، قلت له، بأسماء مختلفة، لكن بنفس المعنى. قال لي: لا، لا، لم أكن أنا. فأجبته: لا بأس، لقد كنتَ أنت، لكن لا مشكلة. فقال: نعم، ربما كنت أنا بطريقة ما”.
وأضاف ترامب: “انظروا، إنه رجل صارم وذكي جدًا. فعل ما لم يستطع أحد فعله، ويجب الاعتراف بذلك.” ثم التفت إلى نتنياهو وقال: “أعتقد أنني قادر على حل أي مشكلة بينك وبين تركيا، ما دمت منطقيًا. عليك أن تكون معقولًا. يجب أن نكون معقولين”.
بعد هذه التصريحات، انهالت الانتقادات في الإعلام الإسرائيلي، بأن إسرائيل لم تعد قادرة على استخدام نفوذها الكامل على الولايات المتحدة.
لكن قوة إسرائيل لا تنبع فقط من اعتمادها على الوجود العسكري الأميركي، بل تمتد إلى شبكات استخباراتية واسعة تديرها عبر جهاز الموساد في الشرق الأوسط، مما يمنحها قدرة هائلة على إثارة الفوضى.
وتشمل هذه القوة تجنيد العملاء، استخدام تقنيات الحرب الخفية، تنفيذ عمليات اغتيال، وتوجيه حملات دعائية إعلامية.
كما أن الأساطيل الحربية الأميركية في البحر المتوسط والقواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة تبقى في حالة استعداد دائم لأي طارئ يهدد إسرائيل، مما يمنحها شعورًا دائمًا بالأمان لتنفيذ استفزازاتها، بما في ذلك قصف دمشق.
وهكذا، تمكنت إسرائيل من تنفيذ جرائمها في غزة، واحتلال المناطق العازلة حول مرتفعات الجولان في لبنان، وسوريا.
ورغم كل هذا، يُصر الرئيس ترامب على قراره المتكرر بسحب القوات الأميركية من سوريا.
وما كشفته وزارة الخارجية الأميركية حول استعداد إسرائيل لضرب دمشق، يعكس بوضوح الخلاف المتنامي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي نفس اليوم، 18 أبريل/نيسان، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيانًا رسميًا يُظهر نيتها عدم الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي، وأعلنت أنها ستخفض عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي.
وجاء في البيان:
“في ضوء النجاحات التي تحققت ضد تنظيم الدولة، بما في ذلك فقدان التنظيم لسيطرته الإقليمية خلال فترة حكم الرئيس ترامب في عام 2019، أصدر وزير الدفاع تعليمات بإعادة تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، لتكون أكثر تركيزًا. تعكس هذه الخطوة التقدم الكبير في تقليص قدرة تنظيم الدولة على المستويين؛ الإقليمي والعالمي.
هذه العملية ستكون متعمدة وتستند إلى الظروف، وستؤدي في الأشهر القادمة إلى تقليص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى حوالي 1000 عنصر.
وفي الوقت نفسه، ستواصل القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات جوية ضد فلول تنظيم الدولة، مع استمرار التعاون الوثيق مع شركائنا في التحالف الراغبين والقادرين على مواصلة الضغط على التنظيم والتصدي لأي تهديدات إرهابية جديدة”.
فهل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟
في عامي 2018 و2019، أعلن ترامب مرتين نيته سحب القوات من سوريا، لكنه لم ينجح. وفي عام 2020، صرّح جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا حينها، بأنهم كانوا يتلاعبون بالأرقام لإخفاء العدد الحقيقي للقوات الأميركية في سوريا عن ترامب، قائلًا: “كنا دائمًا نلعب ألعابًا لخداع القيادة الأميركية بشأن عدد قواتنا هناك. في الواقع، كان عددهم أكبر بكثير من الرقم الذي وعد ترامب به، وهو 200 جندي فقط”.
وأضاف في مقابلة مع موقع Defence One: “ترامب كان ميّالًا للانسحاب بعد دحر تنظيم الدولة، فقررنا في كل مرة أن نجهز خمس حجج أفضل لنبقى هناك، وقد نجحنا في مرتين. هذه هي القصة”.
تصريحات جيفري تؤكد قناعتي بأنه: في أميركا يمكنك أن تُنتخب رئيسًا، لكن لا يمكنك أن تحكم كرئيس. حتى وإن امتلكت السلطة، فقد لا تتمكن من استخدامها، وتظن فقط أنك تستخدمها.
اليوم، إسرائيل هي العامل الأكبر في عرقلة انسحاب أميركا من سوريا، بينما تركيا هي القوة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا الانسحاب.
فإسرائيل لن تتخلى عن مشروعها الصهيوني الممتد منذ 150 عامًا لتحقيق حلم “أرض الميعاد”، ولذلك حتى لو خفضت أميركا أعداد جنودها، فلن تنهي وجودها العسكري الذي يُتيح لها التدخل في أي لحظة.
وتؤكد آلاف الشاحنات المحمّلة بالأسلحة والذخائر التي زودت بها أميركا مليشيات: PKK وPYD وYPG منذ عام 2013، على استمرار هذا الدعم.
وما دامت إسرائيل مستمرة في نهج الاحتلال، فستستمر في الضغط على أميركا أيضًا، مستفيدة من تغلغلها العميق في مفاصل القرار الأميركي؛ في السياسة، والاستخبارات (CIA)، والدفاع (البنتاغون)، ووسائل الإعلام، والفن، والمجتمع المدني.
وقد كشفت تسجيلات صوتية سرّبتها منصة The Grayzone من مؤتمر مغلق لـ AIPAC في عام 2025، أن المدير التنفيذي للجنة العمل السياسي الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، إليوت برانت، تفاخر بتأثيره على شخصيات كبرى مثل مدير الـ CIA جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز.
وأكد برانت في التسجيلات أن هذه الشخصيات لطالما دعمت المصالح الإسرائيلية، وأن AIPAC موّلت حملاتهم وساعدتهم على الوصول لمراكز القرار، مما منحها حق الوصول إلى معلومات إستراتيجية.
الخلاصة: القوة الوحيدة القادرة على فرض انسحاب أميركي كامل من سوريا هي الجمهورية التركية عبر ثباتها في مواجهة الإرهاب.
فمنذ عام 2016، تمكّنت تركيا من إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا عبر عمليات عسكرية ضد تنظيم PKK الإرهابي، وأسهمت في تحجيمه، وأقامت علاقات صداقة وتنسيق مع الحكومة السورية.
نعم، الأمر ليس سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا أيضًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وصحفي تركي
الجزيرة
——————————–
=======================
الموقف الأميركي اتجاه سوريا، مسالة رفع العقوبات، الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية على الحكومة السورية تحديث 23 نيسان 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
العقوبات الأميركية على سوريا الجديدة وسبل إلغائها
———————————
هل تمزق رسائل الاقتصاديين السوريين عقوبات الغرب؟/ سميرة المسالمة
الثلاثاء 2025/04/22
يفترض المتابع للشأن السوري أن الحديث عن إصلاح شامل في سوريا، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، يحتاج بدايةً إلى بيئة مؤاتية للعمل، أهمها قدرة السلطة الحالية على المحافظة على الثقة التي اكتسبتها خلال أيامها الأولى بعد التحرير، من خلال نبذها للخطاب الطائفي وتجريمها عمليات الانتقام. وهذا يعني أنها اليوم مطالبة بتحويل هذا الخطاب إلى إجراءات تجرم فيها الانتهاكات الواقعة في مناطق متفرقة في سوريا، مما يمنع تكرارها أو التمادي في استثمارها من قبل جهات داخلية، أو خارجية، لتقويض عملية الانتقال من سوريا الخراب الأسدي إلى سوريا الشعب السوري، أي أن أولى ملامح الإصلاح في سوريا تأتي من صورتها الداخلية أمام مجتمعها لا من صورتها الخارجية.
صحيح أن العقوبات الغربية تصنع اليوم حواجز تفوق قدرة الحكومة السورية على تجاوزها، أو القفز فوقها، وتتضاعف آثارها الاقتصادية يوماً بعد يوم نتيجة التراكمات التي خلفتها حرب نظام بشار الأسد على المدن والسكان ومنابع الاقتصاد الحيوية، إلا أن للسوريين القدرة على انتزاع حلول إبداعية، من خلال مبادراتهم وتكتلاتهم الاقتصادية التي تترجمها مجموعات عمل تتناوب على انعاش القطاعات الطبية والمصرفية والصناعية، والتجارية. فحيث تبعد العقوبات عادة رؤوس الأموال عن الاستثمار في مواطنها، يمارس كثير من السوريين اليوم التجديف عكس تيار المخاوف، ما يعني أنهم يحررون اقتصادهم من تبعيات الخوف واحتمالات الفشل.
من ذلك، العودة الصناعية السورية التي تعد رسالة ذات أبعاد مجتمعية وسياسية، وتتجاوز كونها مجرد وظيفة اقتصادية، فالثنائية المحيرة بين أولوية رفع العقوبات الغربية عن سوريا أو البدء بالإصلاحات السياسية تحل نفسها بنفسها.
عدم تمكين الحكومة من خلال تقييد حركتها المالية والنقدية، ومنع تدفق الاستثمارات إليها لتأمين فرص العمل واستعادة القدرة على إعادة الإعمار، بدءاً من توفير مستلزمات السلم الأهلي وتأمين ما يضمن استقراره وحمايته، ووصولاً إلى تمكين المجتمع اقتصادياً. هذا الواقع عندها هو ما يمنح السوريين فترة استراحة حقيقية من أعباء ما خلفه نظام الأسد في حربه الدامية، ولعل الخراب الاجتماعي الذي نعيشه اليوم، إصلاحه ليس بأقل تكلفة من غيره.
أي أن تراتبية المطالب يجب أن تبدأ من إزالة العوائق أمام الحكومة للبدء بأعمالها الأساسية، التي هي فوق سياسية، وتشمل انتشال ما يقرب من 90 بالمئة من السوريين من حفرة الفقر المدقع، التي إذا بقيت على حالها، ستأخذ ما تبقى من السوريين إلى هاويتها، ما يعني أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يحظى بالأولوية، لتمكين الشعب الذي يراد له أن يشارك في العملية السياسية، للعيش في ظروف طبيعية، واستعادة سقف بيته المدمر، وتأمين احتياجاته الأساسية بشكل دائم ومستمر، أيما يتجاوز المساعدات الإنسانية، إلى خلق فرص استثمارية تؤمن فرص عمل حقيقية ذات استدامة انتاجية.
والحديث عن مراقبة أداء الحكومة من قبل الغرب، ضمانة لحقوق السوريين بالمشاركة السياسية، ما لم يسبقه ترجمة وعود تلك الدول بالمساعدة وتهيئة المناخات اللازمة لعودة السوريين إلى وطنهم، يعد محاولة فعلية لإبقاء سوريا في متاهة الخراب، والهيمنة واللا استقرار، بالتزامن مع بقائه تحت نيران إسرائيل لزيادة وتعميق “جورة” الدمار التي أوقع نظام الأسد سوريا برمتها فيها.
ثلاث قضايا تشغل السوريين لا يمكن تقديم إحداها عن الأخرى، فإذا كانت الأولوية للاقتصاد فهو يحتاج إلى السلم الأهلي، وإذا كانت الأولوية للإصلاح فهذا يتطلب رفع العقوبات وانسياب الاستثمارات، وكل ذلك يحتاج إلى ثقة متبادلة بين الحكومة والشعب، وهو ما تضمنه العدالة الانتقالية. فما من خطوة يمكن أن تتحقق بمعزل عن غيرها، هي معادلة حاصل جمعها دولة مستقرة، وحاصل طرح أي جزء منها خسارة فادحة لجميع الأطراف.
الأمم المتحدة مهدت أحد الطرق إلى حل خدمي باقتراحها لعب دور الوسيط لصرف الأموال السورية المجمدة في دول أوربية وعربية، أي أنها انتزعت حجج الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية، وكما قال لي الاقتصادي محمد الشاعر “إنه حل يتجاوز العقوبات ويبدد توجسات الدول الأوربية في موضوع العقوبات ومصارف هذه الأموال”. ما يعني أن الطريق مفتوحة أمامنا لاكتشاف الحلول لكل مشكلاتنا، ومن بينها طرائق تعزيز الأمن المجتمعي لتعم علينا فوائد الانفتاح الاقتصادي وتبعاته.
المدن
———————————
إعادة تموضع أميركية في سوريا | واشنطن تغري دمشق: الانسحاب مقابل التطبيع
بدأت الولايات المتحدة خطة لتنفيذ انسحاب جزئي من سوريا على ثلاث مراحل، في انتظار تقييم جديد خلال 60 يوماً، يُحتمل أن ينتهي بالإبقاء على نحو 500 جندي أميركي فقط في الداخل السوري وعدد محدود من القواعد في سوريا، في خطة تهدف إلى تلبية رغبة الرئيس دونالد ترامب في تخفيض التدخل العسكري في الدول الأجنبية. ويأتي هذا في ظلّ تسارع التحولات الإقليمية، وسعي واشنطن لتمرير عرض سياسي – أمني متكامل إلى دمشق، عنوانه الظاهر تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، فيما مضمونه الحقيقي استدراج السلطة الجديدة نحو التموضع في المحور الأميركي، على قاعدة التطبيع مع إسرائيل والعداء الكامل لإيران.
وبالفعل، بدأت الولايات المتحدة انسحاباً جزئياً من خلال إخلاء شبه كامل لأكبر قاعدتين في سوريا، هما: «القرية الخضراء»، المعروفة بـ«العمر» في ريف دير الزور الشرقي، و«الفرات» والمعروفة بـ«معمل غاز كونيكو» في ريف دير الزور الشمالي، بالإضافة إلى قاعدة ثالثة بالقرب من بلدة الباغوز على الحدود السورية العراقية، علماً أن الجنود المتواجدين في تلك القواعد انسحبوا في مسارين: الأول في اتجاه «الشدادي» لتعزيزها، والآخر في اتجاه القواعد الأميركية في كردستان العراق، حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين بارزين. وأوضح المسؤولون أنه «بهذا التحرك، انخفض عدد أفراد الجيش الأميركي من 2000 جندي إلى 1400 جندي». وأضاف هؤلاء أن «القادة العسكريين سيعيدون تقييم الوضع بعد 60 يوماً (…) وسيوصون ببقاء ما لا يقل عن 500 جندي في المنطقة لاحقاً».
بدورها، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بياناً أعلنت فيه أنه «سيتم تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر القادمة»، في خطوة وصفتها بأنها «عملية مدروسة ومشروطة». كما أعلن المتحدّث الرسمي الرئيسي للوزارة، شون بارنيل، عن «توحيد القوات في سوريا تحت قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، في مواقع مختارة». ورأى أن هذا الإجراء «يعكس الخطوات الكبيرة التي قطعناها نحو تقليص جاذبية «داعش» وقدراته التشغيلية إقليمياً وعالمياً».
ويأتي ذلك فيما يبدو أن الأميركيين يواصلون سعيهم لاستمالة الإدارة السورية الجديدة، واستثمار سيطرتها على العاصمة دمشق، لإنهاء وجود حركات المقاومة الفلسطينية هناك، بالإضافة إلى دفع التطبيع مع إسرائيل، وتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» على لائحة الإرهاب، وفقاً لوثيقة مسرّبة لقائمة من المطالب الأميركية من سوريا، مقابل إمكانية رفع العقوبات عن الأخيرة بشكل تدريجي.
ويُحتمل، هنا، أن تكون واشنطن قد نفّذت هذا الانسحاب الجزئي لتأكيد جدية احتمال تسليم دمشق آبار النفط أيضاً، مقابل ضمان قيام نظام سياسي صديق لأميركا وإسرائيل، وخصوصاً أن القاعدتين اللتين تم الانسحاب منهما تقعان في أغزر مناطق انتشار النفط والغاز. كما أن توحيدها القوات العاملة في سوريا تحت لواء عملية «العزم الصلب»، يستبطن رسالة باستعدادها لحماية إدارة الرئيس السوري في الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، من هجمات «داعش» – بعد إعلان الأخير الحرب على دمشق -، وأنها تريد منه التعاون لإنهاء نشاط التنظيم في سوريا ومنع استغلاله للأوضاع الأمنية للعودة من جديد.
ومع ذلك، لم ينعكس الانسحاب الأميركي هدوءاً تاماً على الأرض؛ إذ نفّذت قوات أميركية، برفقة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، جولات على سرير نهر الفرات في دير الزور، وفي بلدة تل تمر في ريف الحسكة، توازياً مع إجراء تدريبات ونقل أسلحة في عدة «قواعد» في ريف الحسكة، وتنفيذ حملة أمنية في مخيم الهول ضد خلايا تنظيم «داعش». وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ خطة لإعادة انتشار في سوريا، كانت مُعدّة حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض» موضحة أن «الخطة تقوم على انسحاب من قواعد ودمج أخرى، وتقليص عدد الجنود الأميركيين من ألفين إلى 500 جندي فقط»، علماً أنه قبل سقوط نظام الأسد بأشهر، رفعت واشنطن عدد جنودها من 900 إلى ألفين.
وتضيف المصادر نفسها أن واشنطن «ستحتفظ بثلاث قواعد رئيسية، هي: قسرك في ريف الحسكة الشمالي الغربي، والشدادي في جنوب الحسكة، مع إنشاء قاعدة جديدة في سد تشرين بريف حلب الشمالي الشرقي»، مرجّحة أن «تركّز في وجودها على استمرار مراقبة أمن مخيمات وسجون تنظيم داعش في مناطق سيطرة قسد في سوريا». وتتوقّع أن «تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 500 جندي، إلى حين استكمال دمج «قسد» في بنية الدولة السورية الجديدة بما يتيح استكمال العمليات ضد تنظيم داعش»، معتبرة أن «هذه القواعد ستبقى أيضاً نقطة ضغط متواصلة على دمشق لدفعها إلى الانخراط في المحور الأميركي، وعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل».
———————————-
هل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟/ نديم شنر
22/4/2025
في مقالي السابق على الجزيرة نت تحدّثت عن تقاطع المصالح بين إسرائيل وتركيا في الملفّ السوري، متناولًا السيناريوهات السيئة المحتملة، فقلت: “لم تُغيّر إسرائيل من إستراتيجيتها باستخدام نفوذها على الإدارة الأميركية، أو استخدام فرع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا، كأداة لتنفيذ سياساتها.
أما الشرور التي قد تقدم عليها فهي واضحة: تنفيذ عمليات تخريب واغتيالات بغرض تغيير الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع في سوريا، وافتعال أعمال استفزازية باستخدام تنظيم PKK الذي يُتوقع أن يعلن حله قريبًا. فكل شيء قد يتغير، إلا إسرائيل التي تدين بوجودها للاحتلال والإبادة؛ فهي لا تتغير”.
لم أكن أتوقع أن تتحقق توقعاتي بهذه السرعة، لكن الحقيقة أنه لا حاجة لأن تكون “منجمًا” لتتوقع أفعال إسرائيل، فمجرد مراقبتها يكفي.
وهكذا، كما توقعت، أقدمت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي على استفزاز جديد.
نُشرَ أول الأخبار عن ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث أفاد موقع “Ynet” أن مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بنيّة الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا تدريجيًا خلال شهرين.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الإسرائيلية لمنع هذا الانسحاب من خلال ضغط دبلوماسي على واشنطن، فإن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها.
وبحسب التقرير، فإن الأوساط الأمنية في إسرائيل ما زالت تواصل ضغوطها على الإدارة الأميركية.
لاحقًا، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” خبرًا يؤكد أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية انسحاب تدريجي من سوريا. وبموجب هذا القرار، سيتم تخفيض عدد الجنود الأميركيين في سوريا من حوالي 2000 جندي إلى 1400، وستُغلق ثلاث قواعد عسكرية من أصل ثمانٍ.
ومن المقرر إجراء تقييم لاحقًا بشأن إمكانية سحب المزيد من الجنود. ومع ذلك، أوصى مسؤولو البنتاغون بالإبقاء على ما لا يقل عن 500 جندي في سوريا.
وفي خضم هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 18 أبريل/ نيسان بيانًا غير اعتيادي حذرت فيه من احتمال وقوع هجوم في العاصمة السورية دمشق.
وأشارت الوزارة إلى معلومات استخبارية موثوقة عن احتمال وقوع هجمات في أي وقت، حتى في أماكن يزورها السياح بشكل متكرر.
وتوقَّعت الوزارةُ أن تشمل الهجمات فعاليات عامة، فنادق، أندية، مطاعم، أماكن عبادة، مدارس، حدائق، مراكز تسوق، أنظمة نقل عام، وأماكن مكتظة، وقد تقع هذه الهجمات دون سابق إنذار.
بطبيعة الحال، تبادر إلى أذهان الكثيرين أن إسرائيل قد تكون وراء هذه الهجمات المحتملة.
ومن الواضح أن هذه التهديدات تأتي في سياق محاولة إسرائيلية استفزازية لعرقلة انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. فهذه الرسائل، التي تستهدف دمشق، موجهة في الوقت ذاته إلى تركيا، وكذلك إلى الرئيس الأميركي ترامب، الذي لم يستجب لمطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
فحكومة نتنياهو ترى في مثل هذا الهجوم فرصة لجرّ تركيا إلى صراع من شأنه أن يوقف قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، ولذلك أعدّت هذا الاستفزاز بعناية.
فالرئيس الأميركي ترامب كان قد صدم نتنياهو بموقفه من السياسة السورية بقوله: “لديّ علاقة رائعة مع رجل يُدعى أردوغان. هل سمعتم بهذا الاسم؟ أنا أحبه، وهو يحبني. أعلم أن الصحافة ستغضب مني، سيقولون: “ترامب يحب أردوغان!” لكنني أحبه، وهو يحبني. لم نواجه أي مشكلات من قبل. عشنا تجارب كثيرة، لكن لم تحدث بيننا مشكلات. وأتذكر أننا استعدنا القس الأميركي من تركيا في ذلك الوقت، وكانت خطوة كبيرة.
قلت لرئيس الوزراء (نتنياهو): “بيبي”، إن كانت لديك مشكلة مع تركيا فأعتقد أن بإمكاني حلّها. لديّ علاقة ممتازة جدًا مع تركيا ومع زعيمها. أظن أننا نستطيع حل الأمور معًا”.
ونقل ترامب أيضًا حوارًا دار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال: “هنّأته وقلت له إنه فعل ما لم يفعله أحد منذ ألفي عام. لقد أخذت سوريا، قلت له، بأسماء مختلفة، لكن بنفس المعنى. قال لي: لا، لا، لم أكن أنا. فأجبته: لا بأس، لقد كنتَ أنت، لكن لا مشكلة. فقال: نعم، ربما كنت أنا بطريقة ما”.
وأضاف ترامب: “انظروا، إنه رجل صارم وذكي جدًا. فعل ما لم يستطع أحد فعله، ويجب الاعتراف بذلك.” ثم التفت إلى نتنياهو وقال: “أعتقد أنني قادر على حل أي مشكلة بينك وبين تركيا، ما دمت منطقيًا. عليك أن تكون معقولًا. يجب أن نكون معقولين”.
بعد هذه التصريحات، انهالت الانتقادات في الإعلام الإسرائيلي، بأن إسرائيل لم تعد قادرة على استخدام نفوذها الكامل على الولايات المتحدة.
لكن قوة إسرائيل لا تنبع فقط من اعتمادها على الوجود العسكري الأميركي، بل تمتد إلى شبكات استخباراتية واسعة تديرها عبر جهاز الموساد في الشرق الأوسط، مما يمنحها قدرة هائلة على إثارة الفوضى.
وتشمل هذه القوة تجنيد العملاء، استخدام تقنيات الحرب الخفية، تنفيذ عمليات اغتيال، وتوجيه حملات دعائية إعلامية.
كما أن الأساطيل الحربية الأميركية في البحر المتوسط والقواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة تبقى في حالة استعداد دائم لأي طارئ يهدد إسرائيل، مما يمنحها شعورًا دائمًا بالأمان لتنفيذ استفزازاتها، بما في ذلك قصف دمشق.
وهكذا، تمكنت إسرائيل من تنفيذ جرائمها في غزة، واحتلال المناطق العازلة حول مرتفعات الجولان في لبنان، وسوريا.
ورغم كل هذا، يُصر الرئيس ترامب على قراره المتكرر بسحب القوات الأميركية من سوريا.
وما كشفته وزارة الخارجية الأميركية حول استعداد إسرائيل لضرب دمشق، يعكس بوضوح الخلاف المتنامي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي نفس اليوم، 18 أبريل/نيسان، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيانًا رسميًا يُظهر نيتها عدم الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي، وأعلنت أنها ستخفض عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي.
وجاء في البيان:
“في ضوء النجاحات التي تحققت ضد تنظيم الدولة، بما في ذلك فقدان التنظيم لسيطرته الإقليمية خلال فترة حكم الرئيس ترامب في عام 2019، أصدر وزير الدفاع تعليمات بإعادة تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، لتكون أكثر تركيزًا. تعكس هذه الخطوة التقدم الكبير في تقليص قدرة تنظيم الدولة على المستويين؛ الإقليمي والعالمي.
هذه العملية ستكون متعمدة وتستند إلى الظروف، وستؤدي في الأشهر القادمة إلى تقليص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى حوالي 1000 عنصر.
وفي الوقت نفسه، ستواصل القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات جوية ضد فلول تنظيم الدولة، مع استمرار التعاون الوثيق مع شركائنا في التحالف الراغبين والقادرين على مواصلة الضغط على التنظيم والتصدي لأي تهديدات إرهابية جديدة”.
فهل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟
في عامي 2018 و2019، أعلن ترامب مرتين نيته سحب القوات من سوريا، لكنه لم ينجح. وفي عام 2020، صرّح جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا حينها، بأنهم كانوا يتلاعبون بالأرقام لإخفاء العدد الحقيقي للقوات الأميركية في سوريا عن ترامب، قائلًا: “كنا دائمًا نلعب ألعابًا لخداع القيادة الأميركية بشأن عدد قواتنا هناك. في الواقع، كان عددهم أكبر بكثير من الرقم الذي وعد ترامب به، وهو 200 جندي فقط”.
وأضاف في مقابلة مع موقع Defence One: “ترامب كان ميّالًا للانسحاب بعد دحر تنظيم الدولة، فقررنا في كل مرة أن نجهز خمس حجج أفضل لنبقى هناك، وقد نجحنا في مرتين. هذه هي القصة”.
تصريحات جيفري تؤكد قناعتي بأنه: في أميركا يمكنك أن تُنتخب رئيسًا، لكن لا يمكنك أن تحكم كرئيس. حتى وإن امتلكت السلطة، فقد لا تتمكن من استخدامها، وتظن فقط أنك تستخدمها.
اليوم، إسرائيل هي العامل الأكبر في عرقلة انسحاب أميركا من سوريا، بينما تركيا هي القوة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا الانسحاب.
فإسرائيل لن تتخلى عن مشروعها الصهيوني الممتد منذ 150 عامًا لتحقيق حلم “أرض الميعاد”، ولذلك حتى لو خفضت أميركا أعداد جنودها، فلن تنهي وجودها العسكري الذي يُتيح لها التدخل في أي لحظة.
وتؤكد آلاف الشاحنات المحمّلة بالأسلحة والذخائر التي زودت بها أميركا مليشيات: PKK وPYD وYPG منذ عام 2013، على استمرار هذا الدعم.
وما دامت إسرائيل مستمرة في نهج الاحتلال، فستستمر في الضغط على أميركا أيضًا، مستفيدة من تغلغلها العميق في مفاصل القرار الأميركي؛ في السياسة، والاستخبارات (CIA)، والدفاع (البنتاغون)، ووسائل الإعلام، والفن، والمجتمع المدني.
وقد كشفت تسجيلات صوتية سرّبتها منصة The Grayzone من مؤتمر مغلق لـ AIPAC في عام 2025، أن المدير التنفيذي للجنة العمل السياسي الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، إليوت برانت، تفاخر بتأثيره على شخصيات كبرى مثل مدير الـ CIA جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز.
وأكد برانت في التسجيلات أن هذه الشخصيات لطالما دعمت المصالح الإسرائيلية، وأن AIPAC موّلت حملاتهم وساعدتهم على الوصول لمراكز القرار، مما منحها حق الوصول إلى معلومات إستراتيجية.
الخلاصة: القوة الوحيدة القادرة على فرض انسحاب أميركي كامل من سوريا هي الجمهورية التركية عبر ثباتها في مواجهة الإرهاب.
فمنذ عام 2016، تمكّنت تركيا من إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا عبر عمليات عسكرية ضد تنظيم PKK الإرهابي، وأسهمت في تحجيمه، وأقامت علاقات صداقة وتنسيق مع الحكومة السورية.
نعم، الأمر ليس سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا أيضًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وصحفي تركي
الجزيرة
——————————–
الشرع يحدد موقف سوريا من الشروط الأمريكية
حدد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، موقف سوريا تجاه الملفات المرتبطة بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع الدول الأخرى والوجود الروسي في سوريا، وتوحيد الجيش واستتباب الأمن، داعيًا واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا.
وقال الشرع، إن أي فوضى في سوريا ستضر ليس فقط بالدول المجاورة بل بالعالم أجمع، وذلك خلال مقابلة في العاصمة دمشق مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نشرتها اليوم، الأربعاء 23 من نيسان.
ودعا الشرع واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا، قائلًا إن من المنطقي رفعها الآن بعد سقوط النظام السابق، وذكر أن “العقوبات تم تنفيذها ردًا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب”.
واعتبر الشرع أن بعض الشروط الأمريكية “تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”، ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل.
وتدور الشروط الأمريكية لتحقيق انفتاح مع دمشق في فلك أربعة مطالب، هي تدمير أي مخازن متبقية من الأسلحة الكيماوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وإبعاد المقاتلين الأجانب من مناصب حكومية عليا، وتعيين ضابط اتصال للمساعدة في الجهود الأمريكية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس.
وذكر الشرع أن حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من تركيا وروسيا، وألمح إلى إمكانية الحصول على دعم عسكري مستقبلي من كلتيهما، وأضاف أن حكومته ألغت اتفاقيات سابقة بين سوريا ودول أخرى، وتعمل على تطوير اتفاقيات جديدة.
وبدا الشرع منفتحًا على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى، وصرّح بأن موسكو زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، ما يعني أن بلاده قد تحتاج إلى دعم روسيا أو دول أخرى مجددًا في المستقبل.
وأضاف، “حتى الآن لم نتلقَّ عروضًا من دول أخرى لاستبدال الأسلحة السورية” التي هي في معظمها من إنتاج روسيا.
وعن الوجود الروسي في سوريا، قال الشرع، “أبلغنا جميع الأطراف أن هذا الوجود العسكري يجب أن يتوافق مع الإطار القانوني السوري”، وأضاف أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تضمن “استقلال سوريا واستقرار أمنها، وألا يشكل وجود أي دولة تهديدًا أو خطرًا على الدول الأخرى عبر الأراضي السورية”.
وأشار إلى أن حكومته ستنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب المقيمين في البلاد منذ سنوات، والمتزوجين في بعض الحالات من مواطنين سوريين، والذين “انضموا إلى الثورة”.
وقال الشرع، إن “سوريا التزمت منذ البداية، حتى قبل أن نصل إلى دمشق، بمنع استخدام أراضيها بأي شكل من الأشكال يهدد أي دولة أجنبية”.
وعن الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري، ذكر الشرع أن حكومته ملتزمة بالحفاظ على السلام في الساحل وسوف تحاسب المسؤولين عن العنف.
وعن بناء جيش موحد، قال إن بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش كفء لدولة بحجم سوريا، معتبرًا أن “هذا بحد ذاته يشكل تحديًا هائلًا، وسيستغرق بعض الوقت”.
وفي 8 من كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد السيطرة على مدن أخرى، وأنهت 53 عامًا من حكم عائلة الأسد، ثم أعلنت الإدارة السورية أحمد الشرع رئيسًا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وحزب “البعث”.
وجرى تشكيل لجنة تقصي الحقائق ولجنة لتعزيز السلم الأهلي بعد مواجهات دامية في الساحل السوري، وتوقيع اتفاق بين أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، نص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.
وتم توقيع إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات، وتشكيل حكومة جديدة حلت مكان حكومة تصريف الأعمال، وضمت 23 وزيرًا.
———————————-
مشرّعان يطالبان إدارة ترامب بتخفيف العقوبات على سوريا دعمًا للحكومة الجديدة
23 أبريل 2025
وجّه العضوان البارزان في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رئيسة اللجنة الديمقراطية جين شاهين، ونظيرها عضو اللجنة الجمهوري جيمس ريش؛ رسالة مشتركة إلى وزيري الخارجية والخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، طالبا فيها بتخفيف العقوبات على بعض القطاعات الحيوية في سوريا، بهدف خلق بيئة مستقرة تسهم في حماية المصالح الأميركية في المنطقة.
وأكد المشرعان في الشيوخ الأميركي في مقدمة الرسالة، التي صدرت بتاريخ 21 نيسان/أبريل الجاري، أن “سقوط نظام الأسد يمثل فرصة نادرة أمام الولايات المتحدة لحماية مصالحها الاستراتيجية”، محذرين في الوقت ذاته من التسرع في التدخل المباشر، وداعين إلى “تهيئة المجال أمام الشركاء الإقليميين والدوليين للتحرك”.
ودعا ريش وشاهين إلى مراجعة شاملة للوائح العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، حيثُ قدما اقتراحًا بشأن “توسيع التراخيص العامة السارية ومنح إعفاءات قصيرة الأمد أو محدودة النطاق”، كخطوات أولية تهدف إلى فتح المجال أمام تحركات فاعلة على الأرض.
وشددت الرسالة على ضرورة تقليص المخاطر الناجمة عن العقوبات الأميركية المفروضة على عدد من القطاعات الرئيسية في البلاد، بينها “الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية لشبكة الكهرباء، والتمويل، والاتصالات، والتعليم”. وأوضحا أن وزارة الخزانة كانت قد أصدرت “ترخيصين عاميّن” سابقًا لهذه القطاعات، غير أن “القيود الزمنية والجغرافية حدّت من الاستفادة الكاملة منهما”.
وفي هذا السياق، حث السيناتوران وزيري الخارجية والخزانة على “توسيع نطاق التراخيص لتشمل مرونة زمنية وجغرافية أوسع للجهات الفاعلة على الأرض”، إلى جانب “اتخاذ خطوات لتخفيف العقوبات على المدى القصير”.
وأشار المشرعان الأميركيان في رسالتهما المشتركة إلى أن مثل هذه الخطوات “توفر انفراجًا سريعًا، وتعزز السيولة في السوق، وتمنع الاضطرابات الآنية، وهي عناصر ضرورية لتحقيق الظروف التي تدعم المصالح الأميركية”.
كما سلطت الرسالة الضوء على أولويات واشنطن “الأمنية الوطنية” في سوريا، وفي مقدمتها “منع تحويل سوريا إلى منصة لهجمات إرهابية، وضمان عدم بقاء روسيا وإيران في البلاد، والقضاء على الأسلحة الكيميائية ومخزون الكبتاغون، إضافةً إلى التعاون للعثور على الصحفي الأميركي أوستن تايس والمواطنين الأميركيين الآخرين المفقودين”.
وبينما أكد المشرعان بأن بعض التقدم قد تحقق في هذه الملفات، إلا أنهما حذّرا من “تباطؤ ملحوظ”، لافتين إلى ورود “تقارير عن مجازر في غرب سوريا، ومحادثات حول استمرار الوجود الروسي، واعتراض شحنات كبتاغون في العراق”، كمؤشرات على استمرار المخاطر.
وشددت الرسالة على أنه “في حال أظهرت الحكومة السورية المؤقتة خطوات لا رجعة فيها نحو تحقيق أولويات واشنطن، فإننا نشجع الإدارة الأميركية على إزالة مزيد من العقبات أمام الانخراط الدولي، بما في ذلك تخفيف شامل للعقوبات”. وبالمثل، حذرت الرسالة من أن الإخفاق في تلبية هذه الشروط سيؤدي إلى تعميق “العزلة الاقتصادية والدبلوماسية”.
كما رحب المشرعان في الرسالة المشتركة بـ”انتهاء مراجعة سياسة الإدارة الأميركية تجاه سوريا”، وأعربا عن تقديرهما لـ”الجهود الرامية إلى إيصال المصالح الأميركية بشكل واضح إلى دمشق”، وأكد أنهما يتطلعان إلى “التعاون مع الإدارة الأميركية لتكييف السياسة الأميركية استنادًا إلى تقدم الحكومة السورية المؤقتة”.
واختتم المشرعان في الشيوخ الأميركي الرسالة بالتنويه إلى رصدهما “تنافسًا متزايدًا بين إسرائيل وتركيا حول مستقبل سوريا”، وهو ما اعتبرا أنه “قد يشكل تهديدًا للمصالح الأميركية”، وعلى هذا الأساس حثا إدارة ترامب “على التحرك بسرعة للتوسط بين حلفائنا”.
————————————–
ملف الأسلحة الكيماوية.. هل تستطيع الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها؟/ أحمد الكناني
22 أبريل 2025
شكّل السلاح الكيميائي في سوريا أولوية دولية وملفًا أمميًا طارئًا منذ سقوط نظام الأسد. وتشير التقديرات التي كشفت عنها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وجود قرابة 100 موقع من المحتمل أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيمائية، وهو عدد يتجاوز بكثير العدد الذي صرح به النظام السابق. وتبدي المنظمة نية واضحة لإغلاق هذا الملف عبر حصر المواقع الدقيقة المرتبطة بالبرامج الكيميائية، والتحقيق في استخدامها، وأخيرًا إتلافها.
وعلى الرغم من تعهدات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لاهاي بتدمير كافة الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، إلا أن مراقبين يرون في الإصرار الأميركي على جعل التخلص من السلاح الكيميائي شرطًا لرفع العقوبات والاعتراف بالحكومة السورية الجديدة “مؤشرًا واضحًا على أن المنظمة ترى أن اجراءات دمشق غير كافية بعد، وهي بحاجة للعديد من الخطوات الفعلية على الأرض”.
مخاوف دولية
يؤكد الحقوقي والناشط في توثيق استخدام نظام الأسد للسلاح للكيماوي، إبراهيم ملكي، أنه جرى التواصل مباشرة منذ سقوط النظام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتم تقديم الدعوة لها لزيارة سوريا والتعاون معها هذه القضية، بعد أن أعربت المنظمة عن مخاوفها بوصول هذه الأسلحة إلى بعض الفصائل الجهادية والخارجة عن سيطرة الدولة السورية، واستخدامها في نشاطات غير شرعية في أماكن مدنيّة.
وأشار ملكي إلى وجود “مخاوف دولية وإسرائيلية متعلقة بتهريب بعض من هذه الأسلحة لحزب الله عبر الحدود إلى لبنان، أو إلى تنظيمات إرهابية مثل “داعش”، لا سيما أن العديد من المواقع الكيميائية تم الكشف عليها في مناطق جبال القلمون، ولهذا السبب هناك إلحاح غربي وأميركي على إغلاق هذا الملف والتخلص من السلاح الكيميائي في سوريا”.
خطوات مطلوبة
يشير الخبراء التقنيون إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُجري أعمالها في تحديد المواقع المحتمل وجود الأسلحة الكيميائية فيها، استنادًا إلى معلومات من مصادر خارجية، سواء عبر باحثين في أوروبا عملوا في مراكز بحثية للنظام السابق، أو باحثين مستقلين، إضافة إلى الأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية قدمتها الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وعليه يؤكد مصدر تقني، مطلع على الملف الكيميائي، أن أحد أبرز المطالب الآنية من دمشق “توفير المناخ المناسب لعمل اللجنة داخل سوريا، وبحرية تامة في تحديد المواقع، خاصة النقاط العسكرية والبحثية المحتملة لتصنيع السلاح الكيميائي، والتي يعتقد أنها مخبأة في كهوف ذات أغراض عسكرية”، لافتًا إلى أن “فريقًا تابعًا للمنظمة حصل بالفعل على إذن بدخول سوريا بهدف التحقق من هذه المواقع، ومن المتوقع أن توسع هذه الفرق من عملها وانتشارها في سوريا”.
المصدر أشار إلى أن أحد أهم المطالب الواجب تنفيذها أيضًا “متعلق بالمسارعة إلى تعيين ممثل لسوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي سيكون صلة الوصل بين المنظمة والحكومة السورية في تنسيق الخطوات الفعلية على الأرض وتنفيذ الإجراءات وتوثيقها، ومن المرجح تعيين المحامي ابراهيم العلبي كممثل لسوريا في المنظمة”.
عملية معقدة
يؤكد المحامي ثائر حجازي أن العملية المتعلقة بتقصي الحقائق ليست سهلة، بل “تأتي نتاجًا لجهود متكاملة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إذ تم العمل سابقًا مع بعثة تقصي الحقائق FFM، والتي تعمل على توثيق الضربات، وإجراء المقابلات مع شهود العيان، وتحديد العينات القابلة للفحص بشأن المناطق التي تعرضت للضربات الكيماوية”.
المحامي حجازي لفت إلى أن العمل يجري أيضًا مع بعثة IIT والتي تعد المسؤولة والمختصة في تحديد الشخصيات المسؤولة عن الهجمات، والوحدات العسكرية التي نفذت هذه الضربات، وآلية تنفيذ الهجمات.
مطلب سوري
يرى إبراهيم ملكي أن “التخلص من السلاح الكيميائي ليس مشكلة غربية وأميركية أو دولية فقط، وإنما هي مشكلة سورية أيضًا، إذ تشير التقديرات إلى أن المناطق المدنية وتحديدًا الكسوة، جمرايا، والمزة.. جميعها مناطق مأهولة صنّع فيها النظام السابق سلاحًا كيميائيًا ما شكل خطرًا على أهالي هذه المناطق، من حيث الانبعاثات أو الاستخدام الخاطئ، وعليه فإغلاق الملف دوليًا يساهم برفع العقوبات، وإزالة الخطر عن المدنيين السوريين”.
تدرج واشنطن التخلص من الأسلحة الكيميائية ضمن عدة شروط لرفع العقوبات عن سوريا والاعتراف بحكومتها، ما يشكل ضغطًا على دمشق التي، حسب مراقبين، تقابل هذا الضغط “بإيجابية من حيث التعاون مع المنظمة والسعي لإغلاق الملف ورفع رصيدها في العلاقات الدولية”.
———————————-
كيف تروّج دمشق لخضوعها للضغوط الأمريكية بوصفه انتصاراً وطنياً أو دينياً؟/ جعفر مشهدية
الثلاثاء 22 أبريل 2025
تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً سياسيةً على الإدارة السورية الجديدة، بقصد تطويعها وفق الشروط الأمريكية، وذلك من خلال إصدار بعض القرارات التي تعرقل مسار الدولة السورية على طريق نيل الاعتراف الدولي، بالإضافة إلى تصريحات بعض كبار المسؤولين الأمريكيين في قضايا عدة مثل أحداث الساحل، الإعلان الدستوري وصلاحيات الرئيس، الحكومة وضرورة تشكيلها على أسس ديمقراطية تشاركية، وخلفية الحكم الجديد الجهادية، وغيرها من الأمور.
الترغيب والترهيب
بعد سقوط نظام الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تعاملت واشنطن مع الملف السوري بعدم اكتراث، في أسلوب يعتمد مبدأ الترغيب والترهيب للضغط على الإدارة السورية الجديدة، التي تحتاج إلى ختم أمريكي يُسهّل لها قضية الاعتراف الدولي ورفع العقوبات.
وبعد أكثر من 3 أشهر على تولّي إدارة الرئيس أحمد الشرع، سدّة الحكم في دمشق، قالت 6 مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، في 25 آذار/ مارس الماضي، إنّ الولايات المتحدة سلّمت لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، وعبر نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ناتاشا فرانشيسكي، قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولّي أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة، وتدمير سوريا لأيّ مخازن أسلحة كيماوية متبقية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وفي 6 نيسان/ أبريل الحالي، أبلغت واشنطن البعثة السورية في نيويورك مذكّرةً تمّ تسليمها من خلال الأمم المتحدة، تنصّ على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة، إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة.
وتضمّنت المذكرّة كذلك إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1، المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3 التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهّلين أممياً للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفةً بحكوماتهم.
وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لقناة الجزيرة القطرية، في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري، إلى أنّ الولايات المتحدة لا تعترف في الوقت الحالي بأيّ كيان كحكومة لسوريا، مع التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيير على امتيازات أو حصانات الأعضاء المعتمدين في البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة.
هل من اهتمام أمريكي بالملف السوري؟
يقول الخبير السياسي باسل حوكان، لرصيف22، إنّ “ترامب يعدّ الموضوع السوري قضيةً سياقيةً وليست أولويةً، فهو ملتفت بالدرجة الأولى إلى الملف النووي الإيراني، أما الموضوع السوري فهدفه تحقيق رغبة إسرائيل وأولوياتها، ومطالب واشنطن تنضوي في هذا الإطار الخادم للمشاريع الإسرائيلية، أما القرارات الأمريكية الأخيرة، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين في واشنطن، وبرغم محاولة البعض التهرّب من تفسيرها، إلا أنها مؤشر واضح على عدم اعتراف أمريكي بالإدارة الجديدة برئاسة الشرع، وهذا سينسحب لاحقاً على الأوروبي والعربي، خصوصاً الخليجي، ما يعني مقتل الحكومة السورية ونهايتها”.
بينما ترى الباحثة المتخصصة في الشؤون الأمريكية هديل العويس، في حديثها إلى رصيف22، أنّ “واشنطن تعدّ ملفات الشرق الأوسط، ومنها الملف السوري، مصدر تشويش لها عن الأهداف الرئيسية، خاصة المنافسة الإستراتيجية مع الصين وضبط العلاقات ومستقبلها مع الدول الأوروبية، وتالياً تحاول منذ زمن الابتعاد عن منطقة الشرق الأوسط ومنها الملف السوري بكل تعقيداته، ودونالد ترامب عبّر عن هذا الموضوع حين قال: لا نملك أصدقاء في الشرق الأوسط، وهي ليست معركتنا”.
وتضيف: “في الوقت نفسه، هناك أشخاص دبلوماسيون مخضرمون في إدارة ترامب، مثل وزير الخارجية، يرون أنّ ما يحدث في سوريا لا يبقى بالضرورة ضمنها ويخرج عن السيطرة ويخرج عن نطاق الأراضي السورية، كما حدث حين خرج تنظيم داعش من سوريا والعراق، وكما تداعيات الثورة السورية حين تم تهجير الملايين وأُغرقت أوروبا ودول الجوار بأعداد كبيرة من السوريين، وكانت لهذا تبعات أمنية واجتماعية واقتصادية على كل الدول، لذلك هؤلاء يرون أنّ هناك ضرورةً بأن يكون هناك بحث عن حلول في سوريا كي لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، وتضطر الولايات المتحدة إلى الانخراط في الملف السوري بشكل أكبر، كما اضطرت إلى الانخراط فيه حين شكلت الحملة الدولية لمكافحة تنظيم داعش بعد سنوات من محاولة أوباما الابتعاد عن سوريا”.
وتتابع العويس: “من الواضح أنّ إدارة ترامب اليوم لا تتعمق في ما يحدث داخل سوريا وفي توجهات الإدارة الجديدة، أو في تفاؤل البعض بأن هذه الإدارة برغم أنها قادمة من خلفية جهادية لكنها تبدي مرونةً كبيرةً وتغييرات كبيرةً إذا قارنناها بخلفيتها، بل تذهب إدارة ترامب نحو الخطاب الشعبوي الذي يقول إنّ هذه الإدارة امتداد لهيئة تحرير الشام التي كانت أحد فروع تنظيم القاعدة وتحاكمها على هذا الأساس، وتقول إنها لن تغيّر هذا الموقف إلا إذا رأت فعلاً تغييرات وتحولات كبيرةً وجذريةً في الداخل السوري”.
في السياق نفسه، يرى الناشط الحقوقي حسين شبلي، أنه “لو أردنا الإجابة وفق الفهم الكلاسيكي للسياسة الخارجية الأمريكية لقلنا بأريحية بأن الملف السوري ربما لا يمثّل قيمةً عاليةً سواء لأمريكا أو لإدارتها الحالية، لكن من يتابع السياسة الأمريكية يدرك أنها لا تستطيع التعامل مع الملفات بمعزل عن بعضها، فالدولة العظمى كلما تحركت خطوةً أفادت دولةً واستعدت أخرى، لذلك يمثل الملف السوري وفق هذا المنطق أحد المسننات في النظام الإقليمي الذي تعتزم خلقه في الشرق الأوسط. لكل ما سبق نشعر بعدم انخراط الأمريكيين في حل المشكلة السورية وتمهلهم، لأنّ ما تعمل عليه إدارة ترامب هو إعادة خلق الاصطفافات الدولية وفق منطق اقتصادي وإدارة كل منطقة من العالم كإقليم لديها فيه شركاء فاعلون تدير التوازنات بينهم بشكل يؤمّن مصالحها دون انخراط مباشر منها، لذا ما يُنتظر من أمريكا ليس وضع الملف السوري على النار الساخنة، فهو دون شك كذلك، لكن بدء ظهور النتائج، وهو أمر لا حلّ سحرياً له بل هو مرتبط بالمنطقة عموماً”.
ما زلنا في عين العاصفة، والمعركة في أوجها
كيف تقاس العدالة في المجتمعات؟ أبقدرة الأفراد على التعبير عن أنفسهم/ نّ، وعيش حياتهم/ نّ بحريّةٍ مطلقة، والتماس السلامة والأمن من طيف الأذى والعقاب المجحف؟
للأسف، أوضاع حقوق الإنسان اليوم لا تزال متردّيةً في منطقتنا، إذ تُكرّس على مزاج من يعتلي سدّة الحكم. إلّا أنّ الأمر متروك لنا لإحداث فارق، ومراكمة وعينا لحقوقنا.
هيّا نخلق واقعاً مغايراً!
ويردف شبلي: “ما يبدو على الولايات المتحدة من تباطؤ في الملف السوري يعود لرغبتها في الاستفادة من الواقع السوري في ملفات أخرى، مثل مفاوضاتها النووية مع إيران ورغبتها في بقاء الشكل الحالي كسدّ في وجه أي رغبة إيرانية في استعادة نفوذها، فترامب لا يريد البقاء في سوريا إلى الأبد، لكنه قبل الانسحاب ينوي خلق سوريا مفيدة لمخططه، وأعتقد أن ترامب يتعامل مع سوريا في المقام الأول كجغرافيا لا كدولة، لجعلها حاجزاً بين نفوذ المراكز الإقليمية، وهي ايران وتركيا وإسرائيل والسعودية، ويتضح هذا من تأكيده لنتنياهو على ضرورة تفاهم أنقرة وتل أبيب في سوريا”.
ماذا تريد أمريكا؟
تذهب الباحثة هديل العويس، إلى أنّ “المطلب الأساسي الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة هو تشكيل حكومة تشمل كل السوريين وتكون تعدديةً وديمقراطيةً، مع التوجه إلى نظام يقبل بالانتخابات ويعطي السوريين الحقوق على أساس المواطنة ويعزز من استقرار سوريا ويمنح السوريين عقداً اجتماعياً يشعر الجميع من خلاله بالعدل، وتالياً لا تحدث حروب أهلية وصراعات داخلية مستقبلية من جديد تُصدر المشكلات إلى خارج الحدود السورية، وهذا لصالح السوريين، كما أنّ هناك مطالب أُخرى تصبّ في صالح إسرائيل، كعدم تفكير النظام السوري في أي طموحات توسعية أو جهادية تستهدف أمن إسرائيل، مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح تركيا في سوريا من قبل إسرائيل”.
بدوره، يؤكد حسين شبلي، أنّ “شروط أمريكا فيها المعلن وغير المعلن، ولا شك في أنها لا تشكل بمعظمها عائقاً أمام تطوّر العلاقة بين دمشق وواشنطن، بل إن حكومة دمشق حريصة على تحقيق أغلبها لمصلحة وطنية بحتة، فالرئيس الشرع أوضح منذ البداية رغبته في ألا تنخرط بلاده في أي صراع خارج حدودها، كما أن المراجعات الفكرية التي أجرتها هيئة تحرير الشام قبل تحريرها دمشق نابعة أصلاً من إدراكها لفشل تجربة الجهاد العالمي وانتقالها إلى ما يشبه النموذج الإسلامي الوطني للحكم المنفتح على الشراكة مع المكونات السورية كافة، وتحقيق مقدار ما من القبول الدولي والمعايير الدولية لما تعنيه دولة”.
يضيف: “يبقى ملف المقاتلين الأجانب إشكالياً بين الطرفين، فالإدارة السورية تقاربه من منطلق اعتبارات محلية لما يمثّله من عامل قلقلة للوضع الأمني الهشّ، لذا تفضّل تأجيل التعامل معه وترى أنّ رفع العقوبات سوف يساعدها في ذلك، فلا استقرار أمنياً خصوصاً في ما يخصّ محاربة داعش دون تحقيق استقرار وتعافٍ اقتصادي، بينما لا تقبل واشنطن في هذا الملف أي حلول وسط، بل على عكس الإدارة السورية تستعجل البت ليس خدمةً للسوريين بل إنّ استعجالها نابع من حرصها على أمن إسرائيل”.
عزلة أو تفاوض تحت الضغط؟
يرى حوكان، أنّ “الكلام عن العزل السياسي الدولي لسوريا مرتبط بأداء الحكم الجديد، وهذا منقسم إلى شطرين؛ الأوّل الرئيس أحمد الشرع والطاقم المحيط به وعلى رأسه وزير الخارجية والوزراء في الحكومة الجديدة، حيث يحاول هؤلاء الخروج من عباءة الأصولية الإسلامية بهدف إزالة مخاوف الغرب وأمريكا، أما الشطر الثاني فمجموعة الفصائل العسكرية ذات الرداء المتشدد السلفي، التي يصعب عليها تغيير عقليتها الجهادية، وهو ما يُنذر بتصادم بين هذين التيارين، وهنا تكمن المشكلة ونصبح أمام خطر تجدد حمام الدم، فالرئيس الشرع حالياً أمام خيارين، إما التناغم مع الفصائل وعدم قتالها ما يضعه أمام خطر العزل السياسي الذي سيفقده الدعم والاعتراف الدوليين ويُنهي مشروعه الذي أعلن عنه بعد سقوط نظام الأسد، أو سيحاول إيجاد حلّ لهذه الفصائل وتغيير موقعها من عقل الثورة إلى عقل الدولة، سواء بالحلول التوفيقية أو القتال”.
وفي سياق متصل، تنبّه العويس، إلى أنه “حتى الآن ما تراه واشنطن لا يقود إلى كسر هذه العزلة السياسية التي تعيشها سوريا، بالطبع لا يمكن مقارنة هذه العزلة السياسية بتلك التي كانت في عهد بشار الأسد الذي برغم تطبيع الدول العربية مع نظامه إلا أنّ الولايات المتحدة لم تكن قد اقتربت بشكل كبير من كسر العزلة عنه أو التفكير في رفع العقوبات، لكن الآن الكل يرى في ما حدث عقب سقوط النظام فرصةً لأن تكون سوريا صديقةً للمجتمع الدولي وقريبةً من المحور الغربي، بعد أن كانت عدوّاً له منذ الحرب الباردة ثم حليفة لأنظمة معادية له وفتحت أبوابها لتكون قاعدةً عسكريةً لإيران. اليوم هناك فرصة لأن تخرج سوريا من هذه العزلة مقابل تطبيق ما تراه واشنطن أهدافاً وشروطاً تصبّ في صالح أمنها القومي وأمن حلفائها وأمن السوريين”.
ومن زاوية أُخرى، يتحدث حسين شبلي، عن فرض عزل سياسي على سوريا. يقول: “من غير الممكن أن تذهب الولايات المتحدة إلى فرض شروطها على دمشق من خلال فرض عزلة دولية جديدة على الحكومة السورية لاعتبارات متعددة، أوّلها أنّ العالم كما قلنا يشهد إعادة اصطفاف دولي وبزوغ نظام دولي جديد وتوازنات إقليمية تديرها واشنطن لضمان مصالحها، والثاني أن سوريا نفسها في وضع مختلف عن وقت فرض العقوبات الأمريكية سابقاً، فالواقع الأمني أكثر هشاشةً والمشهد لم يستقرّ بَعد والوضع الاقتصادي للسوريين أكثر قتامةً وشبه محطم”.
وللأسباب السابقة لا يعتقد شبلي، بأن الولايات المتحدة في صدد فرض حصار دولي على الإدارة الجديدة بل إنها تختصر الوقت وتفاوض تحت الضغط، فـ”واشنطن تدرك كما تدرك الإدارة السورية أن السوريين لا يرون في الشروط الأمريكية ما ينتقص من سيادتهم، لذلك هم لن يقبلوا أي تأخّر في تلبية شروط واشنطن المعلنة لمعرفتهم بأنّ أيّ تحسّن في الوضع المعيشي يبدأ من تخفيف عقوبات أمريكا على سوريا، وهذا للأسف سيترك الإدارة السورية ضعيفةً أمام ما هو غير معلن من الشروط الأمريكية والتي سُرِّب بعضها في الإعلام، كالتطبيع مع اسرائيل والقبول بتوطين الفلسطينيين الموجودين في سوريا، بل استقبال دفعات جديدة من فلسطينيي غزّة بهدف تصفية القضية الفلسطينية”.
ماذا عن الحلول؟
ينطلق حوكان، في حديثه عن الحلول السورية لمواجهة الضغوط والشروط الأمريكية، من أنه “بدايةً يجب أن تبتعد الإدارة الجديدة عن التجريب، خصوصاً بعد عدم التوفيق الذي صاحب الحكومة المؤقتة السابقة وغياب التغيير الحقيقي ضمن الحكومة الانتقالية الحالية، التي لم تنَل حتى الآن قبول الغرب ولم تحقق متطلبات السوريين بالانتقال إلى مرحلة التنمية والإعمار، تالياً لا يوجد أمام الإدارة الجديدة سوى الانفتاح على الآخر، كُلّ الآخر، مع إعادة مؤسسات الدولة والاهتمام بالمؤسسة الأمنية وتأسيس جيش بعيداً عن الحالة الفصائلية التي لا تمتلك أي تجربة عملية وعلمية، وتعزيز القضاء الذي أصابه الشلل مؤخراً، والأهم تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن التمثيل الطائفي أو العرقي قائمة على التوافق بين القوى السورية مجتمعة دون تحاصص أو إقصاء يسهمان في زجّ كل الطاقات السورية في العمل، على أن تتكون من شخصيات لها علاقات داخلية وخارجية متميزة وتملك رؤية لمشاريع تنموية قادرة على أن تعتمد على الذات السورية وتنطلق من خلال الدعم الدولي، بالإضافة إلى كل ذلك يجب نزع المركزية الشديدة في الحكم التي خلقها الإعلان الدستوري”.
أما العويس، فتعتقد أنّ الحلول السورية يجب أن تنطلق من نقطة أنّ “إدارة ترامب غير مقتنعة بفكرة الرئيس الشرع عن ضرورة انسجام الحكومة الحالية، أو أنّ من يدير ملفات الأمن القومي بكل تفاصيله محسوبون على هيئة تحرير الشام، أو جميع الحقائب السيادية في يد الهيئة، فهذا غير مرضٍ لواشنطن ولا ترى في ذلك تغيّراً إيجابياً في دمشق، فما تريده أمريكا، رؤية حكومة أكثر تنوعاً من الشكل الحالي الذي لم تبدِ معه واشنطن أي إيجابية، مع ضرورة أخذ دمشق خطوات منفتحةً عالية الصوت وليست خلف الكواليس، تتعلق بتأكيدها على عدم رغبتها في الانخراط في أي حرب خصوصاً مع إسرائيل، ويكون ذلك من خلال توقيع اتفاقيات، كما تريد واشنطن رؤية عدالة انتقالية واجتماعية في ما يتعلق برموز النظام السابق، بالإضافة إلى المتورطين في أحداث الساحل، وكل هذه المتطلبات تتطلب جهوداً كبيرةً وجريئةً من الإدارة الجديدة لكسر عزلة سوريا، وذلك في سبيل خلق علاقات مع أمريكا التي ستؤدي إلى رفع العقوبات عنها”.
ويرى شبلي، أنّ الإدارة السورية تعي صعوبات النجاح في مهمتها في الحصول على اعتراف دولي نهائي ولا سيّما أمريكي، بغية رفع العقوبات وانطلاق قطار التعافي الاقتصادي دون تنازلات مؤلمة، لكنها في الوقت نفسه تدرك أنها ملزمة بتغليب المصلحة العامة وهو ما أشار إليه الرئيس الشرع، وسمّاه العبور من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، لذا لا سبيل إلى تحقيق توازن معقول بين الإملاءات الخارجية والمصالح الوطنية إلا بترسيخ أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني والشرعية الداخلية للإدارة السورية لتتسلح بهما في أي تفاوض، ما يقلل الثغرات التي قد تنفذ من خلالها الدول الأجنبية لفرض إملاءاتها”.
في النهاية، أوضحت جميع التجارب السابقة إقليمياً ودولياً أنّ أسهل وصفة لحل القضايا السياسية في الدول التي تشهد ثورات مثل سوريا، الإنصات إلى الصوت الداخلي وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، عبر اتّباع نهج تشاركي بين جميع مكونات البلد الواحد، يضمن حقوق الجميع ويحدد واجباتهم تحت مظلّة وطن واحد لجميع أفراده تسود فيه مفاهيم الحرية والعدالة والكرامة.
رصيف 22
————————————–
=======================
العدالة الانتقالية تحديث 23 نيسان 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
———————————
النعيمي: “بطل العدالة الأهلية” في سوريا/ عمر قدور
الثلاثاء 2025/04/22
قبل ثلاثة أيام أقدم حسين النعيمي، في مدينة تلكلخ، على قتل المدعو أسامة “أبو منصور”، حسب التسجيل المصور الذي ظهر فيه معترفاً بعملية القتل. المقتول، حسب ادعاء النعيمي، من قوات أو شبيحة الأسد، وكان يعمل قنّاصاً، وقد قتل العديد من الأشخاص، منهم عمّ النعيمي وصديقه.
ظهر النعيمي مرتدياً البزة التي تميّز أفراد الأمن العام، وقال إنه يوم حادثة القتل كان آتياً من استنفار وعملية في مدينة أخرى. وحسب روايته قدّم الأهالي خلال شهرين العديد من الشكاوى ضد القتيل المتهم بعمليات القتل، فلم تلقَ تجاوباً من الجهات المختصة في المدينة، بل هو يشير إلى تمتع القتيل بحماية تلك الجهات.
يذهب النعيمي أبعد بالقول إن أحداً لم يعد يتجرأ على الشكوى ضد شخص علويّ لأن العلويين محميّون، وأن الشكوى لو كانت ضد سنّي فستبادر الجهات الأمنية إلى اعتقاله بسرعة! إلا أنه، في التسجيل ذاته الذي تقل مدته عن خمس دقائق، ينسى مزاعم الحماية تلك، ويقول إنه لو دفع لـ”السياسية” مبلغ خمسة آلاف دولار لقبضوا على أسامة، أي أنه يحيل بقاءه طليقاً إلى فساد في السلطة ورشوتها من قبل القتيل.
حادثة القتل، دائماً حسب المصدر نفسه، تسبب بها القتيل عندما استفزّ القاتل بإشارة تعني الاستهتار به، أو الشماتة لأنه لا يستطيع التعرّض له، ما دفعه إلى إطلاق النار. السياق يوحي بأنه ليس الاحتكاك الأول بين الطرفين، ويشير النعيمي إلى رؤيته “خصمه” مرات عديدة قبل القتل، أي أنه لم يكن في “فورة دم” وفق التعبير الشائع عن حالات الثأر في لحظة غضب، اللحظة التي تنجم عن اصطدام أول غير متوقع بين الطرفين. وخلال التسجيل كله لم يصدر عن النعيمي ما ينبئ بتأثر عميق، وتعابير وجهه بقيت ثابتة سواء عندما ذكر مقتل عمه وصديقه برصاص القنّاص، أو عندما تحدث عن قتله ذلك القنّاص.
بعد سرد الحادثة يتوعد النعيمي المجرمين الذين قتلوا أناساً في تلكلخ أيام الأسد بالقتل، ويعلن عدم اكتراثه بأي توصيف يُطلق عليه وعلى من معهم، سواء قيل عنهم مجموعات أو فلول، فهم يبتغون مراضاة الله بأرواحهم. وينوّه بأنهم بالطبع تحت “سقف الدولة”، لكنهم لا يقبلون ترك القتلة طلقاء، ليعود للتأكيد على أنه لا يكترث بمراضاة أحد، وعلى أنه “تحت سقف دولة؛ دولة بني أمية ودولة الشرع”!
ثمة تسجيل آخر نُشر بالتزامن مع تسجيل النعيمي، وفيه تظهر صورة ثابتة لثلاثة أشخاص ملثّمين يلبسون الثياب المرقطة، بينما يعلن صوت باسم ثوار مدينة أعزاز عن تشكيل “مجموعة الاغتيالات الخاصة” داخل المدينة. الصوت مموَّه تقنياً بحيث لا يشير إلى هوية صاحبه. ويعلن صاحب الصوت: “كل شخص كانت له علاقات مع النظام البائد هو هدف لنا.. ولدينا العديد من أسماء الذين شاركوا في قتلنا، وقد علمنا أنهم قد عادوا إلى مدينة أعزاز، لكن من الآن نعلن أنهم هدف لنا”.
المصادفة وحدها لا تفسّر نشر التسجيلين في اليوم نفسه، من دون الذهاب إلى الظنّ بوجود تنسيق بين النعيمي من تلكلخ ومجموعة الاغتيالات الخاصة في أعزاز. ما يجمع الاثنين هو مناخ عام من شكوى مفادها تقاعس السلطة عن محاكمة مجرمي العهد البائد، والتذمّر من إبقاء أشخاصٍ طلقاء، بينما يُنظر إليهم على نطاق عام بوصفهم من رجالات ذلك العهد، مثل فادي صقر ومحمد حمشو وسواهما. وكان آخر حدث من هذا القبيل ظهور وزير الثقافة مع السيد جمال الشرع في مضافة شخص من المحسوبين على عهد الأسد، ما دفع الرئاسة إلى إصدار بيان توضح فيه أن حضور شقيق الرئيس كان بصفته الشخصية، من دون أي توضيح خاص بحضور الوزير.
ويمكن ردّ بعض الشكوى والتذمّر إلى سياق طبيعي، انتظر فيه أصحاب الحق أن تبادر السلطة إلى إنصافهم، لكنها بعد مرور شهور والانتهاء من تشكيل الحكومة لم تبادر إلى الشروع في ملف العدالة الانتقالية الموعودة. ولا يمكن إلى جانب هذا السياق إغفال تضخّمه، وتضخيمه المتعمّد، بعد مجازر الساحل. فالضجة الإعلامية التي رافقت المجازر، والمطالبات بمحاسبة مرتكبيها، أيقظت كثرة من المطالبين بمحاكمة مرتكبي المجازر في عهد الأسد، ولا تخفى الكيدية في هذا التضخيم. إذ تبدو المقايضة المتضمَّنة فيها هي مجزرة بمجزرة، وطائفة بطائفة، أو صمت بصمت.
منذ شهر ونصف لم يهدأ الضخّ الذي يستهدف ظاهرُه مجرمي العهد البائد، مع قليل من العتب على السلطة التي لا تحاكمهم، بل تحابي البعض منهم بحسب الشائع. العتب لم يتحوّل ليكون انتقاداً جاداً للسلطة، ومطالبة لها بالشروع في العدالة الانتقالية، وإنما لا يزال يُستخدم لتبرير الانتهاكات في الساحل، الحالية منها والمتوقعة. عمليات الثأر المقبلة مبررة سلفاً بموجب المناخ السائد، لذا لم يكن من المصادفة أن يحظى النعيمي فوراً بالتعاطف على انتقامه على منصات السوشيال ميديا، وأن تنال فعلته تسمية عنواناً يبررها هو: العدالة الأهلية.
والحق أن النعيمي هو أول مَن يطبّق “العدالة الأهلية” المزعومة، فلم تُشتهر منذ سقوط الأسد حادثة ثأر شخصية مشابهة. المقصود هنا، حسب ادعائه، قيامه بالقتل ثأراً لعمه وصديقه وآخرين من معارفه. أما الصيغة الشائعة من الثأر، والتي يُراد تبريرها والألفة معها، فيجسدها الثأر الطائفي الأعمى، حيث يقوم طائفيون سُنّة (ليسوا أولياء ضحايا بالضرورة) بالانتقام من مدنيين من منبت علَوي من دون اكتراث بما إذا كانوا متورطين أو غير متورطين في أي جرم.
الكارثة في منطق الثأر الطائفي، الذي يُراد التعايش معه، ذلك الزعم بتحقيق “العدالة الأهلية” على خلفية العجز عن تحقيق العدالة الانتقالية. والجريمة الفظيعة الكبرى التي تُنفّذ بموجبه هي تجريم طائفة بأكملها لأن الممسكين بالسلطة في أحسن ظن غير قادرين على ملاحقة المجرمين فعلاً، أما بقليل من التشكك فهم يساعدون كبار المجرمين على الإفلات من العقاب، ويتساهلون مع تجريم الأبرياء الضعفاء.
ما تسهل ملاحظته أن النظرة إلى العدالة الانتقالية من قبل السلطة وأهلها قاصرة على موضوع محاكمة المجرمين، وأصحاب هذه النظرة لا يلحظون (عن قصد أو غير قصد) أن العدالة لا تحاكم المجرمين وتنصف ضحاياهم فحسب، بل هي ضرورة ملحّة جداً للأبرياء الضعفاء الذين يجرَّمون على مدار الساعة لأسباب طائفية فقط. وبهذا المعنى فإن عدم الشروع في العدالة الانتقالية لا يُحسب على تسامح تبديه السلطة من أجل السلم الأهلي، بل إنها في هذا السياق تفعل العكس تماماً إذ تتسامح مع كبار المجرمين وتضحّي لأجلهم بالأبرياء، ما يضيف جروحاً جديدة إلى تلك التي تحتاج إلى استشفاء.
حتى كتابة هذه السطور، أي بعد مرور يومين على قيامه بالقتل، لم يُعلن عن القبض على حسين النعيمي الذي خرج معترفاً متباهياً بفعلته، ومتوعّداً بتكرارها، ولم يعلن حتى عن ملاحقته إذا لم يكن على رأس عمله في الأمن العام، ولم يعلن كذلك عن فتح تحقيق في التسجيل المنسوب إلى “مجموعة الاغتيالات الخاصة” في أعزاز. وعدم التحرك يستدعي إلى الأذهان سرعته في حادثة أخرى في اليوم نفسه، إذ أوعز محافظ إدلب إلى المدعي العام لتحريك شكوى ضد ناشطة بدعوى نيلها من الحجاب، وذلك بعد ساعات قليلة من انتشار تسجيل صوتي لها مقتَطع من محادثة خاصة قبل أربع سنوات.
من حيث لا يقصد، يدقّ النعيمي جرس إنذار، هو إنذار حاد ومستعجل على نحو لا يجوز القول أنه لم يُسمع. إلا إذا المطلوب هو التعايش مع دعاة الثأر الطائفي، أو أمثال اللذين ظهرا في تسجيل لتوزيع ربطات خبز على سبيل الإغاثة في حي الفيض في جبلة يوم الأحد، حيث يقول واحد منهم موبّخاً الأولاد (الساعين للحصول على حصة أكبر من المعونة) أن بدو الفيض يستحقون المحو مثل العلوية، ثم يؤكد على أنهم (مثل العلوية) يستحقون التطهير العرقي.
المدن
———————————
سوريا: فرق اغتيال الشبيحة والموالين للنظام تنتشر في المحافظات/ خالد الخطيب
الأربعاء 2025/04/23
تصاعدت عمليات الاغتيال التي تطال مسؤولين وضباط وعناصر سابقين في المليشيات، وشخصيات بارزة تعرف بولائها للنظام السابق، في مدن سورية عدة.
وبلغ عدد عمليات الاغتيال في حلب وحدها، نحو 20 عملية في الشهر الأخير، كذلك سجلت حماة 15 اغتيالاً لشخصيات من فلول النظام في الفترة ذاتها. وتكررت حوادث الاغتيال أيضاَ في حمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور ودرعا وفي الساحل السوري، ومعظم من قتلوا من الضباط والعناصر، كانوا قد أجروا تسويات وأطلق سراحهم خلال الأشهر الماضية.
الاغتيالات تتصاعد
في حلب، طالت عمليات الاغتيال أخيراً، عنصراً سابقاً في “الفرقة الرابعة” بحي صلاح الدين، وقتل طبيب في عيادته في شارع فيصل، بعدما هاجمته مجموعة من الأشخاص المجهولين، وتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر، كما قُتل نائب رئيس فرع المخابرات الجوية في حلب العقيد زهير بيطار، في ظروف غامضة بالقرب من منزله وسط المدينة. واستهدفت العمليات شخصيات مدنية تُتهم بولائها للنظام المخلوع والعمل لمصلحة فروعه الأمنية، بينهم مختار حي صلاح الدين، ومدير الثانوية الشرعية في منطقة السفيرة بريف حلب.
وقال مصدر في حماة لـ”المدن”، إن “عمليات الاغتيال طالت شخصيات معروفة بولائها المطلق للنظام السابق، ومُتهمة بارتكاب مجازر والمشاركة في معظم العمليات العسكرية، بينهم عناصر كانوا يتبعون لطلال الدقاق، أحد أبرز الشبيحة في المدينة، كما طالت الاغتيالات عناصر سابقين في ميليشيا الدفاع الوطني”. وأضاف المصدر أن “معظم من قتلوا سبق أن قاموا بتسوية أوضاعهم مع الدولة”.
مجموعات تتشكل
خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن عن تأسيس مجموعات عدة متخصصة بتنفيذ عمليات الاغتيال ضد عناصر وضباط تابعين للنظام السابق.
وفي منطقة تلكلخ بريف حمص، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها “فرقة قناصي الشبيحة”، أنها ستغتال العناصر والضباط و”الشبيحة” السابقين الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وفي تلكلخ أيضاَ، اعترف حسين النعيمي، وهو عنصر تابع للأمن العام في وزارة الداخلية السورية، بقتل أحد “الشبيحة” السابقين من أبناء المنطقة.
وقال النعيمي في تسجيل مصور تم تداوله على “فايسبوك”، إن المستهدف كان قناصاً على أحد الحواجز وقتل عمه وصديقه في أوقات سابقة. وأكد أنه تقدم بالعديد من الشكاوى ضد الشخص الذي قام باستهدافه، لكن لم يتم الرد عليه، وتوعد بمواصلة تنفيذ عمليات الاغتيال بحق كل من قتل أو أخطأ بحق أهالي المنطقة.
وفي أعزاز شمال حلب، أعلنت إحدى المجموعات في تسجيل مصور، عن تشكيل ما أسمته “قوة المحاسبة الخاصة”، لمحاسبة الأشخاص الذين أجرموا بحق أبناء المدينة وكانوا في صفوف قوات النظام السابق. وحصرت القوة بحسب بيانها المصور، عملها داخل أعزاز، وتوعدت بملاحقة أهدافها من أبناء المدينة في جميع المحافظات السورية التي فروا إليها.
وفي مناطق إدلب تم تداول اسم تشكيل جديد أطلق عليه مسمى مجموعة “مكافحة الشبيحة”.
غياب المحاسبة
ويرى المحامي مصطفى الخطيب، أن عمليات الاغتيال بحق مسؤولين سابقين في النظام السابق، هي شكل من أشكال الانتقام الفردي الذي يمكن أن يقود إلى مشكلات أمنية دموية، وذلك كله بسبب غياب العدالة الانتقالية، معتبراً أن “السلطة هنا تتحمل مسؤولية مباشرة لأنها أغفلت هذا الملف المهم”.
ويضيف لـ”المدن”، أن “تصاعد عمليات الاغتيال يرجع لأسباب عدة، أهمها، كون المؤسسة القضائية الموجودة في الوقت الحالي هي ذاتها التي كانت في زمن النظام السابق، والتغييرات لا تُذكر، لذا ليس هناك ثقة بالقضاء ما يدفع الناس إلى أخذ ما يرون أنها حقوق بأنفسهم”. أما السبب الثاني، بحسب الخطيب، هو خطأ التسوية التي تمت بموجبها مسامحة الجناة، ويقول: “الدولة يمكن أن تعفو بما يخص الحق العام أما الحقوق الشخصية ليس للدولة حق بالعفو عنها”.
ويشير الخطيب إلى أن “القسم الأكبر من حوادث الاغتيال يجري خلال مواقف انفعالية، لأن ترك الجناة طلقاء يمشون بين الناس وفي الأسواق، وبعضهم ربما يتفاخر بأنه حر طليق ومن دون محاسبة برغم كل المصائب التي ارتكبها، يثير غضب الناس ممن تضرروا خلال السنوات الماضية، إما قُتل أقاربهم أو اعتقلوا أو دُمرت منازلهم بسبب هؤلاء الأشخاص الذين كانوا مقربين من النظام السابق وفروعه الأمنية”.
المخاوف من تصاعد عمليات الاغتيال، جدية جداً، وشريحة واسعة من السوريين ترى أن سببها تأخير العمل بمسار العدالة الانتقالية. ويرى المحامي يوسف حسين، في حديث لـ”المدن”، أنه “يتوجب على الحكومة السورية البدء بمحاسبة المتورطين بدماء الشعب السوري وتركتهم يسرحون ويمرحون على مرأى من أعين ذوي الضحايا، وإلا فسيخرج الآلاف من الذين يريدون ثأرهم وانتقامهم وسيحققونه بأيديهم”. ويرجح أن تستغل ظاهرة الاغتيالات من قبل ما أسماهم “فلول النظام” لتتصاعد أكثر وتسود حالة من التوتر والفوضى الأمنية التي قد تعم البلاد.
———————–
=======================