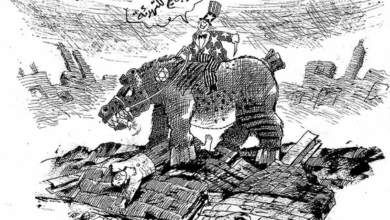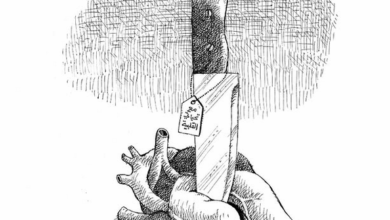عن الأحداث التي جرت في الساحل السوري أسبابها، تداعياتها ومقالات وتحليلات تناولت الحدث تحديث 23 نيسان 2025

لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
الأحداث التي جرت في الساحل السوري
———————————
في المسألتين العلوية والسنّية/ حسين عبد العزيز
22 ابريل 2025
بلور دعم العلويين للنظام وعياً سُنّياً في جزءٍ منه صحيح من حيث مطابقته الواقع، وفي جزئه الآخر مضاعفاً تجاه العلويين، فلو اتصف النظام بالحكم الرشيد، ولو قدّمت الطائفة العلوية مشروعا سياسيا حداثيا، لما نشأت الريبة تجاه العلويين، ولما تضاعفت إشكاليّتهم في الوعي الجمعي السُني الثائر.
لا يمكن فصل أسئلة الديمقراطية والمواطنة والعدالة الانتقالية وطبيعة النظام السياسي عن المسألة الطائفية في المجتمعات العمودية (حيث تتداخل البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية معاً)، فالطائفية هنا جزءٌ أصيلٌ من هذه الأسئلة، بمعنى أن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب طرح الإشكال الطائفي بكل شفافية، خصوصاً وضع الطائفة العلوية في الحالة السورية.
ولكي يكون طرح المسألة العلوية عقلانياً وموضوعياً، يجب الإجابة عن سؤالين رئيسيين: هل كان النظام السوري في عهد الأسدين طائفياً أم سلطوياً؟ وهل كان العلويون، كجماعة لها هُوية فرعية مثل جميع الهُويات الأخرى، طائفيين مناهضين في تفكيرهم وسلوكهم للأكثرية السُنية؟… على الرغم من أن الإجابة عن السؤالين صعبة، إلا أن محاولة تقديم إجابة عنهما ربما تساهم في فهم الإشكال وتجاوزه على المستوى الوطني في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها سورية.
نظام الأسديْن
النظام الطائفي هو الذي يُخصص موارد الدولة لأجل هدف محدّد، رفع مستوى الطائفة التي ينتمي إليها على حساب باقي الطوائف. إذا ما بدأنا بالصعيد الديني لوجدنا، من جهة، أن أول ما قام به حافظ الأسد القضاء بالقوة على أي محاولة علوية لبناء مرجعية دينية، حتى لا تتحوّل الطائفة إلى كتلة ذات وزن اجتماعي ـ هُوياتي، يمكن لها أن تلعب دوراً خارج دائرة منظومة النظام الحاكم. ولوجدنا، من جهة ثانية، أن الأسد لم يسمح بشرعنة أي دين على مستوى الدولة، سوى المذهب السُني، المسموح له فقط بالتعبير عن ذاته مؤسّسياً وتعليمياً باعتباره يُشكل هوية سورية، إلى جانب حرّية العبادة للمسيحيين، أما الطوائف الاخرى، فلم يكن يُسمح لهم بإظهار الطقوس الدينية علناً.
على مستوى الاقتصاد، لم يكن نظام الأسد في توزيعه للأعطيات طائفياً، فقد كان يغضُ الطرف عن كل بارونات النظام، بمعزلٍ عن انتمائهم الديني والطائفي، فالأعطيات وعمليات التجارة الشرعية وغير الشرعية كانت توزّع تبعاً لمقتضيات السلطة فقط (الولاء).
وعلى الصعيد الاجتماعي، حرص الأسد الأب على بقاء العلويين فقراء في قراهم، حتى يكونوا خزّاناً داعماً للنظام، لأن التاريخ ونتائج التحليل السوسيولوجي يؤكّدان أن الوفرة الاقتصادية ستؤدّي بالضرورة، إلى التفكير البراغماتي المتعارض مع بنى التفكير العضوية.
وعلى المستوى السياسي، لم يعمل النظام على تحويل العلويين إلى طائفة سياسية من شأنها أن تتحوّل إلى كتلة تاريخية سياسية قادرة على فرض نفسها، فهذا كان خطّاً أحمر، فما هم إلا أدواتٌ في خدمة النظام، ومن يحاول الاعتراض يُقتل على الفور.
ويؤكّد احتياج نظام الأسد الطائفة العلوية أنه، مثل أي نظام سلطوي مهما بلغت قسوته، يحتاج إلى تحالفاتٍ اجتماعيةً متعدّدة الهُويات، على الرغم من أن البنية القسرية له قائمة على الجيش والأجهزة الأمنية، وإذا كانت الأخيرتان تؤكّدان تمركز السلطة عموديا، فإنهما غير كافيتين لتوسيعها أفقياً. ولهذا احتاج الأسد أربعة أركان لضمان توسيع سلطته واستمراريتها:
أولاً، ضرورة تماهي الطائفة العلوية مع النظام، بإحياء مظلومية تاريخية وتضخيمها أيديولوجياً، وعبر توسيع توظيف أفراد الطائفة في جميع مؤسّسات الدولة، رابطاً بذلك حاجتهم الاقتصادية من جهة وبذاكرتهم التاريخية من جهة أخرى من أجل ربط مصيرهم بمصير النظام. ثانياً، التحالف مع البرجوازية السنية الفاعلة، وهو تحالفٌ سرعان ما تحوّل إلى تزاوج بين السلطة والمال. ثالثاً، إدخال أفراد الريف في مؤسسات الدولة كافة، خصوصاً المؤسستين العسكرية والأمنية (أغلبيتهم سُنة)، من أجل القضاء على الهيمنة السياسية والاقتصادية التاريخية لدمشق وحلب. رابعاً، اعتماد أيديولوجيا قومية عابرة للطوائف، تضع القضية الفلسطينية في القلب منها.
وفق هذه المعطيات التاريخية، لم يكن النظام طائفياً، بل كان سلطوياً رثّاً بامتياز، استغل الذاكرة التاريخية العلوية الممتلئة بالمظلومية التاريخية لتدعيم سلطته، ولم يكن اختيار حافظ الأسد العلويين للمناصب الحساسة نابعاً من أيديولوجية طائفية علوية، بقدر ما كان نتاجاً لما تتطلّبه السلطة، إنها العصبية بالمعنى الخلدوني.
الطائفة العلوية
بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالطائفة العلوية، فهو السؤال الأصعب والأكثر تعقيداً: أن تُرحب الطائفة العلوية بوصول شخصٍ منها إلى رئاسة الجمهورية (حافظ الأسد) وتدعمه، فهذا طبيعيٌّ ومفهومٌ ومبرّر، كما هو حال أي طائفة وإثنية غيرها.
لكن ما حصل منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعيْد أحداث حماة (1982)، أن النظام أمنن الطائفة العلوية وعسكرها، وشيئاً فشيئاً، أخذت الطائفة بعموميتها تجد نفسها جزءاً أصيلاً من النظام: ظهر ذلك عبر تسهيل انخراطهم جماعياً في العمل في مؤسّسات الدولة، خصوصاً الأمنية والعسكرية، على حساب غالبية أبناء الطائفة السنّية الذين وجدوا صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة حكومية.
وظهر ذلك عبر استهجان أي عملية نقد فردية للنظام من خارج الطائفة، والأمثلة لا تُعد ولا تُحصر، إلى درجة أن أحداً لا يجرؤ على نقد الأسد أمام أي علوي، مع حالات استثنائية نادرة. المقصود من هذا أن الطائفة العلوية وجدت في النظام عصباً لها، بقدر ما وجد الأخير فيها عصباً له. ومن هنا، كانت للطائفة مصلحة قوية ببقاء نظام الأسد الأب والابن، كما كانت لنظام الأسديْن مصلحة قوية ببقاء العلويين جزءاً أصيلاً من ترتيباتهما الداخلية.
ولا يعني ذلك كله أن ثمة تماهياً كلياً بين الطائفة والنظام، فهذا غير ممكن عملياً، فكثير من العلويين، بمن فيهم المؤيدون للنظام، غير راضين عن سلوكه الداخلي، لكن ثمة فارقاً هاماً بين عدم الرضا هذا والخروج عليه: لقد كان النقد أو عدم الرضا ينبع من داخل الوحدة، لا من خارجها، ولهذا استمرّ العلويون في دعم بقاء النظام دائماً في كل الأوقات، بما فيها العصيبة منها.
وأي محاولة من بعض الأشخاص للحديث عن وقوف سوريين علويين مع المعارضة ضد نظام الأسد هو قول حق يُراد به باطل، فالاستثناء لا يُلغي القاعدة، ولا تنفع هنا محاولة الفصل بن النظام والطائفة العلوية، ولا تنفع أيضاً محاولات بعضهم اعتبار العلويين مجرّد أدوات داخل مشروع الدولة الأمنية، ففي ذلك تقليل من قيمة العلويين بتحويلهم إلى مجرد قطيع لا فكر ولا إرادة لهم.
لم تكن العلاقة المتداخلة بين الطائفة والنظام قائمةً على أيديولوجيا دينية، أي بنظام المعتقدات الديني، ولا بمصالح اقتصادية واسعة، بل من أجل هُوية علوية، وهذا ما يدفعنا إلى النظر إلى الكينونة السياسية في فهم سلوك الطائفة.
يتعلق الأمر بالمستوى السياسي عند المفترق التاريخي الذي انتقلت فيه الطائفة العلوية من طائفةٍ اجتماعيةٍ منغلقةٍ خلال قرون عديدة إلى طائفةٍ اجتماعيةٍ منفتحةٍ منذ مرحلة الاستعمار الفرنسي، ثم إلى طائفة سياسية وسمت تاريخ سورية المعاصر بشخص حافظ الأسد، وانعكس ذلك مباشرةً في وعيها الجمعي، ونشأت أنا جمعية متضخّمة، تقطع مع التاريخ الغابر، وترفض استذكاره، وترفض أيضاً فكرة تغيير الواقع الحالي، مع ما يستجلبه ذلك من مآسٍ في مخيّلة الوعي الجمعي للطائفة، قد تنالها من الحكّام الجدد إذا ما سقط النظام. وهذا ما يُفسّر نجاح النظام بتحويل الطائفة العلوية بعد الثورة إلى خزّانٍ بشريٍّ رئيسٍ في القتال، ذلك أن مخاطرة الفرد بتعريض حياته للموت يتطلّب أكثر من مجرّد ترويع أمني أو منافع اقتصادية أو سياسية.
وقد بيّنت تجارب التاريخ العديدة، خصوصاً في الحروب، أن الحوافز المؤثّرة في سلوك البشر، ليست اقتصادية، فهي الأقل ثباتاً وديمومة، وإنما الحوافز الأكثر خصوصيةً للنفس البشرية، مثل العاطفة الدينية أو العصبية الهُوياتية. وبهذا المعنى، يشكّل هذا النوع من العواطف، إلى جانب الأيديولوجيا العُصبوية، الآليات الرئيسة التي تصوغ اللحمة بين الطائفة والحرب في أوقاتٍ معينة. وهذا ما يفسّر، أيضاً، كيف أن الطائفة العلوية، في عموميّتها، لم تنظر إلى مطالب الثورة عام 2011 أنها مطالب حداثيةٌ ترمي إلى إسقاط نظام دكتاتوري بوليسي لصّ، من أجل بناء دولة الحرية والديمقراطية والمواطنة، بقدر ما نظرت إلى هذه المطالب من منظارٍ طائفيٍّ، هو عودة الهيمنة السُنّية.
أهي علوية سياسية؟
بيّنت الأحداث منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي حجم الانطواء العلوي على الذات، فلم نشهد ظهور قيادة جماعية موحّدة ممثلةً للعلويين قادرة أن تعبّر عنهم وتعبر بهم إلى أمان سياسي من النخبة الحاكمة، حتى بعد التطمينات التي قدّمها الشرع مباشرة أو من خلال رجاله إلى العلويين في الأسابيع الأولى التي أعقبت سقوط النظام.
يؤكد ذلك زيف مقولة “العلوية السياسية” التي ردّدها كثيرون، وأولهم صادق جلال العظم، حين اعتبر هيمنة المكون العلوي على مفاصل الدولة الحساسة كافيةً لنعت هذا المصطلح باعتباره حقيقة قائمة، وبهذا تصبح “العلوية السياسية” مرتبطةً بالشخوص لا بالبرامج السياسية وطبيعة النظام السياسي.
ويُفهم من كلام العظم أن “العلوية السياسية” ظاهرة استثنائية، ولا تكمن استثنائيّتها في طبيعة العلاقات المتداولة في المنظومة السلطوية، ولا في دورها السياسي كمنظومة إنتاج معرفية ـ سياسية، وإنما تكمن استثنائيّتها في أن العلويين كأقلية يستأثرون بحكم بلدٍ يطغى عليه السُنة.
والحقيقة أن هيمنة علويين على المفاصل الخطيرة في النظام لا يؤدّي، بالضرورة، إلى وجود “علوية سياسية” على غرار “المارونية السياسية” في لبنان، ويا ليت “علوية سياسية” نشأت في سورية، فلو حصل ذلك لاضطرّت إلى ترك مسافة مع النظام من أجل تقديم نموذج سياسي يسمح لها بالاستمرار كجماعةً سياسية، مع ما يتطلبه ذلك بالضرورة من تقديم نموذج سياسي حداثي.
وسواء كان النظام هو الذي منع نشوء “علوية سياسية” أم أن هذا الأمر كان خارج المُفكر فيه لدى العلويين، فإن وقوف الطائفة بالعموم إلى جانب النظام، لا سيما بعد اندلاع الثورة، يؤكّد انعدام وجود هذه الظاهرة السياسية، فأقصى ما كانت تأمله الطائفة بقاء نظام الأسد مع تحسين سلوكه الداخلي سياسياً، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، أي بقاء مكامن القوة الاجتماعية كوعي هُوياتي، وهذا منوطٌ ببقاء النظام.
من الجانب السُني، بلور دعم العلويين للنظام وعياً سُنّياً في جزءٍ منه صحيح من حيث مطابقته الواقع، وفي جزئه الآخر مضاعفاً تجاه العلويين، فلو اتصف النظام بالحكم الرشيد، ولو قدّمت الطائفة العلوية مشروعا سياسيا حداثيا، لما نشأت الريبة تجاه العلويين، ولما تضاعفت إشكاليّتهم في الوعي الجمعي السُني الثائر. هنا، يبدو من المهم طرح سؤال حقيقة العلويين، بخلاف ما ذهب إليه البعض حين اعتبر سؤالاً غير مهمّ.
لكي يخرج هذا السؤال من العباءة الطائفية إلى العباءة الوطنية، وجب أن يشمل كل مكوّنات المجتمع، لأن معرفة حقيقة هُوية المكونات السورية تسمح لنا بإصدار حكم سياسي يبدو ملحّاً اليوم، ولنا في المثال الدرزي ما يؤكد ذلك، فذهاب وفد درزي سوري إلى إسرائيل يفرض، بالضرورة، طرح سؤال حقيقة الدروز، أو على الأقل حقيقة بعض منهم، إنه سؤال الهُوية الضروري في هذا المفترق التاريخي الذي تمرّ به سورية. وينطبق الأمر نفسه على الأكثرية السُنية، المطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بكشف حقيقتها، أهي مشروع وطني جامع، أم هيمنةٌ سُنّيةٌ بلباسٍ سياسيٍّ متنوّعٍ في الظاهر، كما كان حكم الأسد: دكتاتورية فجّة تحت غطاء تعدّدية حزبية.
ما العمل؟
وفقا لما تقدّم، يمكن أن أحاجج بأن المكوّن العلوي اليوم هو أكثر المكوّنات استعداداً للانخراط في مشروع وطني جامع، لا بسبب حالة الخوف الجماعية لديهم حالياً، ولا بسبب تعميةٍ أو تقيةٍ سياسيةٍ لتمرير الوقت فحسب، بل والأهم لأنهم خبروا حقيقة النظام خلال السنوات الخمس الماضية تحديدا، وشاهدوا كيف انتهى حكم الأسد اللص.
لقد أدركوا الآن أن آل الأسد كانوا يستغلون الطائفة لحماية عروشهم ليس إلا، وأن نظام الأسد رمى الطائفة على مذبح الثورة.
وبهذا، يمكن القول إن الحالة العلوية اليوم تعبّر عن حالة سياسية خام، فإما أن يُدفع بهم إلى الانطواء على أنفسهم وإعادة تكرار الماضي، أو أن يُدفعوا إلى الانخراط في الدولة الجديدة.
لا توجد لدينا معطياتٌ واضحةٌ يمكن من خلالها إطلاق أحكام سياسية محدّدة تجاه الحكم الجديد في سورية، فلا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان يُمارسون تقية سياسية، ظاهرها الانفتاح على كل المكوّنات الاجتماعية وإشراكها في الحكم الجديد، وباطنها الاستئثار السُني بالحكم، عبر إعادة إنتاج عصبية سنّية على غرار ما فعل الأسد بإنتاج عصبية علوية.
في جوهر المشروع السياسي الحديث الذي يُنتجه الشرع، شكلاً من أشكال التنافر الأنطولوجي، فما يحدثُ عملية إقصاء واضحة لجميع مكوّنات المجتمع السوري على المستوى السياسي، في وقتٍ يعدُ فيه الشرع السوريين بمرحلة سياسية تقطع مع استبداد النظام السياسي. والسلوك السياسي للحكم الجديد ذي اللون والمسار الأوحد يفتح الباب أمام أطراف داخلية كثيرة لتلمّس مساراتها السياسية والهُوياتية بعيداً عن الدولة. في هذه المفاصل التاريخية الفارقة في الدول والمجتمعات، يكون للفاعل السياسي الدور الرئيس، إما بأخذ البلد إلى برّ الأمان أو دفعه إلى التهلكة.
وفي الحالة السورية المعقدة، لن يكون أمام الحكّام الجدد سوى سبيلين: الأول، اعتماد النهج الإيراني القائم على هيمنة التيار الديني المتشدّد، سواء في مرحلة الخميني، عندما قرّرت النخبة الحاكمة المتشدّدة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، ليس بإقصاء التيارات اليسارية فحسب، بل إقصاء الشخوص الإصلاحية داخل التيار الإسلامي.
السبيل الثاني، الارتقاء إلى مستوى استلهام نهج نيلسون مانديلا إذا استطاع الشرع وأركان حكمه إلى ذلك سبيلاً، باعتماد أسلوب مانديلا السياسي، حين ارتقى بنفسه فوق الخلافات، بوصفه رئيساً لكل الشعب، وحين مدّ يده إلى قادة ثوريين آخرين يتبعون أيديولوجياتٍ ومصالح إقليمية مختلفة جدّاً، في وقت كان فيه قادراً على الاستفراد بالحكم، غير أن بصيرته كرجل دولة فرضت عليه اختيار التشارك السياسي لا الإقصاء.
وإذا ما افترضنا أسوأ السيناريوهات، وهو الخيار الأول، فالحلُّ، بالنسبة لباقي مكوّنات الشعب السوري، لا يكون باعتماد السلاح كما حصل في الساحل من فلول نظام الأسد، ولا بالارتماء في الحضن الإسرائيلي كما فعل بعض الدروز، وإنما بإعادة تجميع سياسية لكل القوى من أجل ممارسة الضغط السياسي، مدعومين بشخصياتٍ كثيرة من السُنة ليست راضية على شكل الحكم الجديد وجوهره.
العربي الجديد
——————————
عندما تنفجر ألغام التاريخ في الساحل السوري/ منير شحّود
21 ابريل 2025
طرحت الأحداث الأليمة التي اشتعلت ليلة 6 مارس/ آذار 2025 في الساحل السوري مزيداً من الأسئلة المتعلقة بالاجتماع السوري عامة، وفي المنطقة الساحلية على وجه الخصوص، بما في ذلك تحوّل المزاج الشعبي السوري العلوي نحو التفكير في طلب حماية أجنبية، وذلك بسبب ما اقترفته في مدنيين عزّل بدموية فصائل غير منضبطة أو تابعة للفصائل المنضوية تحت مسمى وزارة الدفاع في الدولة السورية الجديدة، والتي اتخذت من المدن الساحلية منطلقًا لها للتنكيل بالقرى العلوية المحيطة، بعد هجوم مجموعة من فلول النظام على مواقع عسكرية تابعة للسلطة وحواجز الأمن العام.
تهدف هذه السطور إلى تقصي العلاقة التاريخية بين سنة المدن الساحلية والعلويين منذ تشكيل دولة العلويين في عام 1920 وحتى التحاقها التام بالدولة السورية أواخر عام 1945، ومحاولة الربط بين مجريات الأحداث الحالية والالتفاف على ما نصت عليه معاهدة 1936 من استقلال مالي وإداري لمحافظة اللاذقية.
دولة العلويين
بعد حوالي عامين من نزول قواتها في اللاذقية، أنشأت سلطة الانتداب الفرنسية دولة للعلويين في 2 سبتمبر/ أيلول 1920، ثم أنشأت ثلاث دول سورية أخرى (دمشق وحلب وجبل الدروز). كان إنشاء دولة خاصة بالعلويين نقلة نوعية في تاريخهم السياسي أسهمت في تعزيز الهوية العلوية وتطويرها، ولم يكن سقفهم آنذاك يتجاوز التبعية المباشرة لرؤساء عشائرهم.
أُطلقت على هذه الدولة تسميات عدة بين عامي 1920 و1936، وكان إطلاق تسمية حكومة اللاذقية في 1930 للتخفيف من تسمية دولة يشكل فيها العلويون أغلبية الثلثين فقط. كان للمنطقة الغربية من سورية ما يميّزها بالفعل، ومنه ارتباطها التاريخي بساحل سورية الطبيعية الجنوبي (لبنان وفلسطين)، بحكم التقسيمات الإدارية في العهدين المملوكي والعثماني، نظراً إلى تبعية سنجق اللاذقية لولاية طرابلس أو بيروت أو عكا، وليس للداخل السوري الذي كان يتبع لولايتي دمشق وحلب.
أثار وضع الساحل السوري تحت الحماية الفرنسية المباشرة، المتمثلة بسلطة المفوض الفرنسي في بيروت، مخاوف سنة المدن الساحلية، فكانوا الداعم الأساسي لثورة الشيخ صالح العلي الذي كان قد آثر الاستجابة لدعوة الشريف حسين بن علي للهجوم على القوات التركية المنسحبة من سورية أواخر عام 1918، ومن ثم دعم ابنه الأمير فيصل مقاومة القوات الفرنسية من أجل أن يُتوج ملكاً على سورية. بذلك كانت ثورة العلي من مصلحته الشخصية ومصلحة فيصل ومؤيديه من سنّة المدن الساحلية، لكنها أوحت بوجود تيار علوي عريض مؤيد للوحدة، الأمر الذي لم يكن واقعيّاً آنذاك. ففي بداية 1920، كان التيار الوحدوي بقيادة صالح العلي ضعيفاً بين العلويين، ولو أنه كان مدعوماً من زعامة عشيرة المتاورة في مصياف وقليلين من الزعامات العلوية الأخرى، بينما كان التيار الاستقلالي العلوي هو الأقوى، وقد فضّل أنصاره العمل في إطار دولة العلويين أو الانضمام إلى دولة لبنان الكبير، التي كانت قد تأسست في أغسطس/ آب 1920. لكن، وعلى أرضٍ سياسية متحرّكة باستمرار، فاز التيار العلوي الوحدوي في نهاية فترة الانتداب، بشرط تحقيق الاستقلالين، الإداري والمالي، لمحافظة اللاذقية حسب ما جاء في معاهدة 1936، إذ اشترط مرسوم ضم محافظة اللاذقية إلى سورية أن يكون لها ميزانية خاصة ونظام إداري خاص و16 نائباً في البرلمان.
وفي أثناء محادثات 1936، قامت في محافظة اللاذقية مظاهرات رافضة للوحدة ومظاهرات أخرى مؤيدة لها، كما أُرسلت البرقيات والعرائض إلى عصبة الأمم المتحدة والعواصم الفاعلة، معبرة عن قلق الأقليات بشأن توحيد سورية، وذلك بينما كانت المباحثات تجري بين الفرنسيين الذين أرادوا أن يكون للعلويين وضع خاص مع الإبقاء على حامية عسكرية فرنسية في المنطقة، ووفد الكتلة الوطنية التي تريد توحيد منطقة الساحل السوري مع سورية الأم بصورة تامة، فكان الاتحاد مع سورية بشرط الاستقلال المالي والإداري حلًّا وسطًا .
وخطت الأخيرة خطوتين متكاملتين للتقريب بين العلويين والكتلة الوطنية، فعيّنت حليفها العلوي عزيز هواش محافظًا لدمشق (1936)، بينما أعطت زيارة “وفد بلاد العلويين” إلى دمشق دفعاً جديداً لأنصار الوحدة، وذلك بما حظي به الوفد من تكريم واهتمام إعلامي، فعقد، فور عودته إلى الساحل، اجتماعين سياسيين في كل من القرداحة وطرطوس للتشجيع على الوحدة مع سورية، ولكن بشرط الاستقلالين، المالي والإداري، المذكورين آنفاً.
وكان الخلاف حول القوانين العلمانية التي وردت في المرسوم الانتدابي رقم 60 (1936) قد احتدم بين العلمانيين والدينيين في ظل سلطة الانتداب، إلى أن حسمت حكومة لطفي الحفار، التي خلفت حكومة جميل مردم بك في فبراير/ شباط 1939، المسألة، وشكلت لجنة لدراسة نظام الطوائف، فأقرّت اللجنة العودة إلى الشريعة الإسلامية. وافق المفوض السامي على إلغاء العمل بالمرسوم 60 وحصر تطبيقه بغير المسلمين فقط، 30 مارس/ آذار 1939. وبما أن مفتي القدس الحاج أمين الحسيني، كان قد أصدر فتوى في يوليو/ تموز 1936 اعتبر فيها العلويين مسلمين، ربما كان ذلك مثل رشوة لقبولهم الانضمام إلى سورية، فلم يعودوا يشكلون طائفة مستقلة وانضووا في إطار الشريعة الإسلامية طائفة مسلمة.
الكتلة الوطنية تناور
اشتكى العلويون بين عامي 1937 و1939 بأن بلادهم لم تحصل على الحكم الذاتي كما نصت عليه المعاهدة الفرنسية -السورية، وأن الحكم المركزي فُرض عليهم وتجاهلت السلطات حقوقهم. وفشل محافظ اللاذقية إحسان الجابري في تهدئة الوضع ولم تتعدَّ سلطاته مدن الساحل، فأُقيل عام 1939. وفي 12 يناير/ كانون الثاني 1942 ضمتْ محافظة جبل العلويين رسميّاً إلى سورية، ونشر النظام الأساسي لها بالقرار رقم 23/ ف. ل، والذي أُدرج ملحقاً لمعاهدة 1936، وجاء فيه أن هذه المحافظة تتمتع باستقلالين، مالي وإداري. ومن الواضح أن الكتلة الوطنية، ومعها معظم زعامات سنة الساحل، كانت تناور للتخلص من شرط الاستقلال المالي والإداري (النسبي) لمنطقة العلويين وتنتظر الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك، مخافة أن تنفصل هذه المنطقة عن سورية الأم، ولا سيما أن غالبية سكانها من العلويين. وبقي الأمر معلّقاً بين مطالب الكتلة الوطنية التي تعتبر وحدة الأجزاء السورية “حقّاً جوهريّاً”، ومطلب الاستقلال الإداري والمالي لمنطقة الساحل السوري. ونظراً إلى أن العلويين كانوا منقسمين حول مسألة الوحدة، وأن فرنسا هي من فاوضت عنهم، عملت الكتلة الوطنية على النفاذ من هذه الثغرة والمضي في الإجراءات التي أفضت في النهاية إلى تمرير الوحدة التامة من دون مناقشة كافية في المجلس النيابي، واعتبار موضوع الحقوق الإدارية في الساحل السوري مجرد “وضع شاذ”!. ففي غمرة “الابتهاج الوطني” بقرب جلاء القوات الفرنسية عن سورية، أعلن نائب جبلة، جمال علي أديب، في جلسة البرلمان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 1945، تنازل مقاطعته عن الاستقلالين، المالي والإداري، وحذا باقي نواب محافظة اللاذقية حذوه، بما في ذلك النواب العلويون. وبذلك انتصرت إرادة الكتلة الوطنية بصورة شبه قهرية، وإذا أضفنا إلى ذلك الممارسات القمعية لحكومة جميل مردم بك بحقّ العلويين بعد الجلاء، فربما ساهم ذلك، إضافة إلى عوامل أخرى، في تقويض حكم الكتلة الوطنية لاحقاً، من خلال سلسلة الانقلابات العسكرية التي كان للضباط العلويين دور مهم فيها.
اللحظة التي لم يتم اقتناصها
كان سكان محافظة اللاذقية في 1936 منقسمين بين من يريد الاتحاد مع سورية بصورة تامة أو شبه تامة ومن يريد الانفصال عنها بصورة تامّة أو شبه تامّة أيضاً، ولكن فكرة الحل اللامركزي، من خلال الاستقلال المالي والإداري، وحَّدت المتنازعين؛ أي العلويين والسنة والمسيحيين والإسماعيليين. بالفعل، كان خيار الحفاظ على خصوصية منطقة الساحل مناسباً لجميع سكانه، ويمكن أن يساهم في وحدتهم على أساس المصلحة، لكنه لم يكن ليتوافق مع سياسة الكتلة الوطنية التي حكمت سورية بُعيد الاستقلال، خاصة أن سورية الداخل كانت تحتاج إلى منفذ بحري. وفي هذه النقطة بالذات، تكمن استماتتها لضم الساحل بصورة تامة أواخر عام 1945. كما كان يمكن لما جاء في معاهدة 1936 أن يبدد النمطية التاريخية للعلاقة بين السنة والعلويين والمسيحيين في الساحل السوري. إنها اللحظة التاريخية التي لم تُلتَقط بسبب فيضان المشاعر العروبية التي ستتحول إلى “عماء سياسي” في العقود التالية.
من جهة ثانية، يمكن تفسير قبول النواب العلويين لإلحاق محافظة اللاذقية بلا شروط بالدولة السورية بعدة عوامل، أهمها شعورهم بضعف الدور الفرنسي وهيمنة الإنكليزي عليه في نهاية الحرب، علاوة على ما ارتكبته سلطة الانتداب في 29 مايو/ أيار 1945 بقصفها مدينة دمشق وتدمير البرلمان، بعد رفض الدولتين السورية واللبنانية توقيع اتفاقيات خاصة مع فرنسا، فقد أثار العدوان الفرنسي تضامناً وطنيّاً شمل مناطق العلويين أيضاً.
لاحقاً، سبّبت مرحلة الاستبداد الأسدي زيادة الشرخ الاجتماعي المكبوت بين العلويين والسنة، بسبب زيادة المساحة التي تحرك فيها العلويون في الفضاء الساحلي وامتيازات المرتبطين منهم بالسلطة الحاكمة، الأمر الذي انعكس سريعاً بعد سقوط النظام أواخر عام 2024، فسعى معظم سكان المدن من السنة إلى الاستقواء بالسلطة الجديدة، وشكل بعضهم نوعاً من الحاضنة الاجتماعية للفصائل المتطرّفة التي ارتكبت المجازر بحق المدنيين العلويين، في حين وقف آخرون إلى جانب جيرانهم العلويين، وتعرضوا للقتل أحياناً ثمناً لموقفهم الإنساني هذا.
أخيراً
كان شرط الاستقلال المالي والإداري لمحافظة اللاذقية هو الأمر الذي وافقت عليه جميع الأطراف في المحافظة، كما ورد أعلاه، وكانت لحظة مهمّة يمكن أن تحقق استقراراً مهمّاً مبنيّاً على مصلحة جميع سكان المحافظة. وربما لم يكن الاستبداد الأسدي ليجد له موطئ قدمٍ في سورية، بما تضمنه شرط الاستقلال المالي والإداري من خدمة للمجنّدين ضمن محافظتهم.
لم يعد بالإمكان الخروج من الحالة الراهنة باستخدام وصفات سياسية تقليدية، انطلاقاً من فكرة استمرار الحكم المركزي المعادل للاستبداد، إذ يحتاج الأمر إلى نوع من الحوكمة اللامركزية على كامل مساحة الدولة السورية، خاصة في المناطق الثلاث (الجزيرة والساحل وجبل الدروز)، التي عارض معظم سكانها الانضمام التام إلى الدولة المركزية، وظهر ذلك جليّاً بعد سقوط النظام الأسدي. يتيح النظام اللامركزي، بدرجاته المختلفة، حرية أكبر في إدارة المكونات السورية شؤونها الخاصة والحفاظ على تقاليدها وخصوصياتها الثقافية والدينية، في إطار المواطنة المتساوية للدولة المدنية الديمقراطية المتعثرة.
العربي الجديد
———————————
=======================