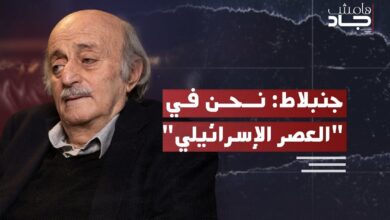عزّة طويل: مطلوب من الرواية خلق عالم يمكن تصديقه

دارين حوماني
23 أبريل 2025
في مقاله عن رواية “لا شيء أسود بالكامل”، يقول عباس بيضون: “هذه الكتابة هي ما فوق حدثية، إذ إنّ الوقائع هنا ذات شقَّين، سرد للواقع وتعالٍ عنه، تسجيل له واستيحاء منه، ونظم له أدبيًا إلى درجة تحاذي أحيانًا الشعر، ولا أعني بذلك الإنشاء الشعري، وإنما الشعر كروح وكرؤية”… هكذا تمامًا يمكن أن تُقرأ رواية الكاتبة عزّة طويل، وهي رواية تلتصق بالواقع وبالتخييل وبالشعر وبنا، نحن المسكونون في مكانين وزمنين، والهاربون من مدينة لمدينة، نبحث عن ذواتنا أولًا، وعن حياة لا تنقلب علينا.
“لا شيء أسود بالكامل” (دار هاشيت أنطوان- نوفل، 2024) هي الرواية الأولى لعزّة طويل التي هاجرت من لبنان إلى كندا عقب انفجار مرفأ بيروت، وعقب ما آلت إليه بيروت من سقوط وخسارات. وإن كانت عزّة دخلت عالم الأدب والكتابة والنشر وعاشت في داخله زمنًا قبل أن تقول أول ما لديها، فقد “قضت نصف حياتها”، كما تعبّر، مع “شركة المطبوعات للتوزيع والنشر” قبل هجرتها، ومنذ فترة وجيزة عادت كمديرة لنفس الدار من مكان إقامتها في كندا، كما تكتب في الصحافة الثقافية منذ سنوات في صحيفة المدن الإلكترونية وموقع رصيف 22.
هنا حوار معها:
(*) لسنوات وأنت تعملين في عالم النشر، في شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، تتلقين عشرات، بل مئات الكتب من شتى المجالات، ماذا أعطاك هذا العمل، هل شكّل عالم النشر هذا المعمار الروائي الذي تملكينه أو كان له تأثير عليه؟
عملي كناشرةٍ أعطاني الكثير من دون أيّ شكّ، لا سيما لناحية القراءات والترجمات والعمل التفكيكي الذي تدفعك إليه عملية النشر والتحرير. منذ سنواتٍ طويلةٍ لا يمرّ يومٌ واحد لا أقرأ خلاله. قراءاتي المفضّلة هي في مجال الرواية والأدب، لكن عملي اضطرّني مثلًا إلى قراءة كتبٍ تتناول مواضيع متنوّعة جدًا، من السياسة، والتاريخ، والاقتصاد والقانون إلى الفلسفة وعلم النفس وغيرها. أعتقد أن هذا عامل أساسيّ لأيّ كاتب: أن ينوّع قراءاته ولا يكتفي بالروايات، وهي نصيحةٌ قالها لي مؤخّرًا علمٌ من أعلام الشعر والأدب والنقد، فنبّهني إلى تأثير تنوّع القراءات في مدى اطّلاع الكاتب وقدرته على الكتابة، فنحن نكتب ما نعرفه، وما نتوصّل إليه، حتى (بل لا سيما) عندما نكتب الأدب. علمًا أن عملي كناشرة كان أساسًا نتيجة شغفي بالأدب، واختياري القراءة وسيلةً فعليةً للاستمتاع وتهدئة النفس من عمرٍ مبكر. سؤالٌ طرحته على نفسي مرّات: هل كنتُ لأكتب لو لم أعمل في النشر؟ والجواب دائمًا نعم قاطعة وجازمة.
(*) “لا شيء أسود بالكامل” رواية الموت والحياة إذا جاز التعبير؛ تبدأين “إنه ثالوث الموت، لقد غادرها ثالوث الحياة”، وتنتهين “كانت هذه رحلة مع الحياة والموت”… الموت مكثف في الرواية بأشكال متعددة، لماذا اخترت الموت كأنه شخصية روائية كاملة في عملك؟
لأن الموت شخصية واقعية في حياتي وفي حياة كلّ كائنٍ حيّ، ولأن له ثقلًا ينهك المرء إن لم يتصالح معه، علمًا أن هذا التصالح صعبٌ للغاية، كما أننا لم نعطَ يومًا أيّ إرشاداتٍ للتعامل معه. شيءٌ أساسيّ ومهم لي أردت قوله في “لا شيء أسود بالكامل” هو أن الموت يلقي بثقله علينا سواء “طرق بابنا” بشكلٍ مباشر أم لم يفعل. بمعنى آخر، جزءٌ من التصالح مع الموت يتعلّق بتتبّع آثاره في مسار الأحياء، وفهم تأثيره الفعليّ فينا كأفرادٍ لكلّ منّا قصّته الفريدة مع الموت. ذلك أن موت الجسد ليس الشكل الوحيد للموت، كالمرأة التي تعيش حياةً تصفها بالموت مثلًا. كما أن له تأثيراته التي نتشرّبها عبر علاقة أهلنا بالحياة والموت. الموت دائرة تحيط بنا منذ لحظة ولادتنا، دائرة نستطيع رسمها إذا نظرنا إلى حياتنا، لكننا رغم ذلك نجهد كثيرًا لنتصالح معها، ومن المرجّح حتى ألا يتمّ هذا التصالح أساسًا.
(*) تقولين في الرواية “في مدينة مثل بيروت، على المرء التروّي قبل اتخاذ قرار الموت”، ثمة كثير من الشعر في هذه العبارة وفي معظم مفاصل الرواية، هل تؤمنين بتلاقح الأجناس الأدبية وتداخلها؟
أؤمن بأن الفكرة حالةٌ شعرية، وفي “لا شيء أسود بالكامل” دفقٌ من الأفكار التي اختارت الأدب وسيلةً، والرواية شكلًا، للتعبير عنها لكنّها لم تُحدّ بقالب جاهز. أؤمن أيضًا بأن فكرة الأجناس الأدبية هدفها تسويقيّ أكثر منه أدبيّ، ولا أقصد هذا بشكلٍ سلبي بالضرورة، بل بمعنى أن الأجناس تهمّ الناشر أكثر ممّا تهمّ الكاتب. أجد أن الأدب تجربة، وهذه التجربة قد تتضمّن تجريبًا أو لا، وهذا التجريب قد يستعين بدوره بتلاقح الأجناس، عن قصدٍ أو دونه. لا أحبّذ شخصيًا الكلام عن قواعد تحدّ جنسًا أدبيًا وكأنها تسجنه، وكلّما حرّرنا الكتابة من القواعد الجاهزة كلّما كان ذلك أفضل في رأيي الشخصي، على أن يظلّ النصّ أدبًا ممسوكًا طبعًا. بل إنني أذهب أبعد من ذلك بعد بأن أقول إن اتّباع لائحة من الشروط وكأنها لائحة بقالة نشتريها هو ضعف لا رقيّ أدبي.
(*) تنتقدين في روايتك مسألة غلاء شراء القبر في بيروت “من ذا الذي يسمح لنفسه بقبض آلاف الدولارات كي يمنحك سينتميرات قليلة تدفن فيها أحباءك؟”… في نقدك هذا، هل كنتِ تطرحين سؤالًا أخلاقيًا عن commodification of death “تسليع الموت”، أم أن الأمر يتجاوز ذلك ليكشف عن أزمة أعمق تتعلق بكرامة الإنسان في المدينة المعاصرة، حتى بعد موته؟
هذه حقيقة أليمة ترتبط بزمننا المعاصر وتتعلّق ببيروت وبغيرها من المدن أيضًا. ففي كندا الأمر كذلك أيضًا. الموت مكلفٌ على ما يبدو في أيّ مدينةٍ معاصرة، مقارنةً بالضيعة مثلًا، حيث “الأمر أسهل. الأرض أسرع استقبالًا للجثث، كما أن التربة أشهى”. الموت حقٌّ، والدفن حقٌّ للجميع ولا يمكن لعقلي أن يتقبّل أن يتمّ التفريق بين الناس في الموت أيضًا، وأن يُنتهك الموت بحسابات الدولارات.
نحن جيل الحرب…
(*) تعودين في روايتك إلى مشهديات عشناها ونحن أطفال، “كنا مسجونين في تلك الأيام، نتنقل بين الملجأ والبيت… نعم جميعنا ترعرع في الملاجئ”، يقولون إن أول رواية يكتبها روائي تكون قادمة من سيرته الذاتية، ماذا تقولين في ذلك؟
أقول إن العمل الأول غالبًا ما يحمل تقاطعات مع حياة كاتبه، والتقاطع الأكبر يكون في رأيي مع الخلاصة التي يريد الكاتب إيصالها عبر كتابته. أما في موضوع الحرب تحديدًا، فمن غير الممكن أن يكتب المرء عن بيروت في الثمانينيات من دون أن تكون الحرب جزءًا مما سيكتب، علمًا أن كلّ كاتبٍ يركّز على ما يريد، ويبني على الحرب، أو حولها، أو يضعها في الخلفية فقط. نحن جيل الحرب، كما أولادنا جيل كورونا مثلًا، وأتوقّع طبعًا أن تُطَعَّم كتابات جيل كورونا بتأثيرات كورونا بشكلٍ أو بآخر كما طُبعَت كتاباتنا بتأثيرات الحرب.
(*) في الرواية نقرأ عن آمال التي ستهرب من الموت في بيروت إلى حمص وهي لا تعلم أنها ستهرب من حمص بعد سنوات لنفس الأسباب… ما غايتك من هذا التشابك بين بيروت وحمص، هل هي اليوميات المأساوية المشتركة؟
هو تشابكٌ تاريخيّ بين لبنان وسورية، وتشابكٌ في مصير الكثير من العائلات العربية التي شهدت وتشهد على مجازر. هو مصير الشعوب التي تسلّل الموت إلى يوميّاتها ولم يرد أن يغادر. هو أيضًا تشابك يجمع بين ملايين العائلات العربية، ويتعلّق بتسلّل العنف، والخلافات، والتصدّع إليها، بغضّ النظر عن الثقافة أو العلم أو الجغرافيا المحددة التي تحضنها (أو لا تحضنها في حال كلّ من لبنان وسورية). غايتي الإضاءة على وحدة المأساة بتعدّد أشكالها، والتجربة الإنسانية التي تبدأ بالموت وتنتهي إليه في بلادنا، ويموت المرء فيها ما بين الموتين بدل أن يحيا.
(*) حين تقولين في خاتمة روايتك “لم تكن هذه قصة قوامها الخيال الخالص بل كانت أيضًا جزءًا من حياة”، فهل تشيرين إلى تجربة شخصية عشتِها، أم إلى واقع جماعي تشعرين بضرورة تمثيله أدبيًا؟ وكيف ترين حدود التخييل حين يتقاطع مع التجربة الذاتية أو التاريخ المشترك؟
في الواقع ما أردتُ قوله يتعلّق بشكل الأدب، الرواية تحديدًا، وبدوره. فالمطلوب من الرواية بجميع أنواعها أن تخلق عالمًا يمكن تصديقه، والمطلوب من الرواية الواقعية بشكلٍ خاص أن تعكس واقع الحياة. أما الحياة، فليست ذات شكلٍ مكتملٍ دائمًا، والرواية تستطيع أن تكون “جزءًا من حياة”.
أما عن حدود التخييل، فهذا مجالٌ أحبّ التفكير والحديث فيه. هناك درجاتٌ من التخييل يمارسها الروائيّ أثناء الكتابة، من إعادة استخدام أحداثٍ صارت، تاريخية أو واقعية، إلى خلق عالمٍ كاملٍ انطلاقًا من شعورٍ محدّد عاشه، أو البناء على شخصياتٍ واقعية يعرفها لمنح شخصيّاته بعدًا صادقًا مقنعًا، فما حدث بالفعل مقنعٌ دائمًا وإن بدا مستحيلًا، لكن حدوثه كافٍ لجعله صادقًا. قد يلجأ الكاتب أيضًا إلى قراءاته ليبني عليها عملية تخييلٍ ما، وقد يعمل على الترميز كجزء من العملية الإبداعية التي تَستثمِر في الخيال، إلى ما هنالك من درجاتٍ من التخييل تؤدّي كلّها إلى العمل الروائي. حين يمثّل الممثّل دوره، غالبًا ما يلجأ إلى اختراع قصّةٍ “خلفيّة” للشخصية التي يؤدّيها كي يتمكّن من تمثّلها سينمائيًا، ويحتاج في ذلك إلى مخيّلته، وعصارة تجاربه وتجارب غيره التي شهد عليها أو قرأ عنها، إضافةً طبعًا إلى السيناريو، ومساندة المخرج وإدارته. هذه كلّها يفعلها الكاتب وهو يرسم شخصيّاته في ذهنه وعلى الورق، ومن دون أيّ مساعدةٍ خارجية، وهي كلّها طبقات تخييلٍ تتقاطع بشكلٍ كبيرٍ أو صغيرٍ مع الواقع، والتجربة الذاتية، والتاريخ…
(*) يقول بودلير في عمله “سأم باريس”: “الميناء مقام جميل لروح متعبة من صراعات الحياة”، وأنت هاجرتِ إلى كندا بعد انفجار مرفأ بيروت، وكأنكِ غادرتِ مدينة متعبة من صراعات الحياة ولم تعد تُحتمل الحياة فيها لتبحثين عن مرفأ آمن في مكان آخر. ما الذي تعنيه لك بيروت اليوم؟
كنتُ متعبةً جدًا من بيروت حين غادرتُها، فالانفجار أعاد إلى السطح كلّ تروما الماضي. وفكرة التاريخ الذي يكرّر نفسه أرهقتني، بما في ذلك الدمار، والانهيار الاقتصادي، وفوضى المصارف، واحتمالات الاشتعال الدائمة، وكلّ ذلك في سياق وباءٍ أرعبنا وهزّ دواخلنا وثوابتنا كلّها. ألحّت عليّ فكرة المغادرة ولم أرِد حتى الانتظار إلى أن تصل أوراق الهجرة إلى كندا، فانسحبتُ مع عائلتي إلى إسطنبول. “هلّق بدنا نفلّ”- جملةٌ أذكر كيف استبدّت بي بعد الانفجار، وصارت المغادرة هاجسًا حينها، ذلك أن آليات دفاعنا الفطرية انفجرت هي أيضًا، وفُعِّلَت في جسمي آلية الهروب، لا إلى ميناء راحة، بل إلى مكانٍ انتقاليّ أنتظر فيه هجرةً ثانيةً وأحاول جاهدةً استيعاب ما حدث. في إسطنبول، تابعتُ عملي عن بعد وزارني أهلي مرّاتٍ عدة، كما كانت صديقتي المقرّبة تسكن على بعد عشر دقائق مني، فلم أشعر بوقع الانفصال كما شعرتُ به بعد وصولي إلى كندا، الميناء المرتقب. لكن الأحداث التي ظلّت تتعاقب على بيروت ووقعها عليّ أكّدا لي أن الانفصال أمرٌ أصعب من المتوقّع، وأعترف أنني لم أتمكّن من تجاوزه بعد، لا سيما أن فيها يقيم أقرب الناس إلى قلبي.
(*) تعيشين في كندا، وتعملين في دار نشر عربية، هل هي عملية تخفيف من مخزون الشعور بالمنفى فينا، وعدم القدرة على الانفصال عن العالم العربي، وكأننا نعيش هنا وهناك في الوقت نفسه، أو العيش ضمن منطقة الـ ما بين؟
الكتابة بالعربية هي وسيلتي الأولى حاليًا للتخفيف من الشعور بالبعد. أشعر بحاجةٍ إلى الكتابة بالعربية، وألبّي هذه الحاجة كلّما استطعت، لأن عوامل الانفصال تتكثّف هنا، بسبب فرق التوقيت، واللغة اليومية، والطقس، وطريقة الحياة، والطعام، وحتى اللبس (بسبب الطقس). دائمًا ما أقول إن اللغة العربية أمي، وأقصد هذا حرفيًا ومجازيًا، لأنها لغتي الأم فعليًا، ولأنها ترتبط بشكلٍ مباشر بأمّي وأبحاثها في اللغة، وتدريسها النحو والأدب، وكتاباتها التي أثّرت بي، كما أنها اللغة التي تنساب تعابيري بها كماء يعود إلى منبعه. أما النشر، فتركته لفترةٍ ثم عدتُ إليه مؤخّرًا علمًا أنني لم أتخلّ عن العمل الثقافي المرتبط بالعالم العربي، وأعتقد أن هذه العودة إلى العمل مع “هُناك” انطلاقًا من “هنا” ستزيد من صعوبة استكمال الانفصال، وهو أمرٌ لا أعرف كيف سيؤثّر عليّ، لكنني أرى حسناته وسيّئاته بوضوح.
(*) كونك تقيمين في كندا الإنكليزية وأنت متمكنة لغويًا، هل تفكرين في ترجمة روايتك إلى الإنكليزية بنفسك؟ وهل الأفضل برأيك أن يقوم الروائي أو الشاعر بترجمة عمله بنفسه أو يقوم بالمهمة مترجم متخصص أدبيًا؟
ترجمة “لا شيء أسود بالكامل” أحد مشاريعي المقبلة، وأعتقد أن على الروائي أن يكون جزءًا من الترجمة متى أمكنه ذلك لغويًا، بمعنى أنه إذا سلّمها إلى مترجم، فعليه ألا يتغاضى عن الاطّلاع على الترجمة والتأكّد من الإحساس الذي تنقله، وما إذا كان يتلاقى مع الإحساس الذي أراده الكاتب في اللغة الأصل.
(*) هل ترين أهمية في تقديم أعمالنا للقارئ الغربي بأنفسنا لفقدان الدور الفاعل عربيًا لهكذا مشاريع، والتي ستقوم بكل الأحوال على العلاقات العامة أكثر من مستوى العمل نفسه؟
هو بالفعل دورٌ محدود، بل الأحرى دورٌ لا يُتاح بشكلٍ مهنيّ سوى لعددٍ قليلٍ من الكتّاب العرب، ما يحتّم على الكاتب أن يجهد بنفسه في سبيل تعريف “الآخر” بكتابته. وهذه حالةٌ تتكرّر في كندا مثلًا حيث تبرز محاولات فردية، غالبًا بتمويلٍ ذاتيّ، ينجزها كتّابٌ عرب لترجمة أعمالهم إلى الإنكليزية، لكن هذه الأعمال غالبًا ما تبقى محدودة الانتشار خارج الدوائر القريبة من الكاتب بسبب غياب الدعم المهني والمادي وغيرهما. ولهذا السبب تحديدًا، طوّرتُ مؤخّرًا فكرةً وكتبتُ تفاصيلها ومخطّطها تتعلّق بهذا النوع من التبادل تحديدًا، وأتمنى فعلًا أن أجد القدرة على متابعتها في الوقت المناسب، فهناك حاجةٌ حقيقية إلى تفعيل تبادلٍ حيّ بين الناشرين والكتّاب الكنديين ونظرائهم العرب، ينتِج دورةً حيّة لا تُستنفد مع الوقت.
ضفة ثالثة