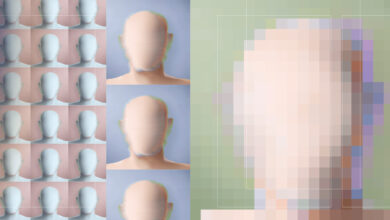نقيض المدينة: من هم «أبناء الضواحي»؟/ محمد سامي الكيال

تبدو الاضطرابات الاجتماعية، التي تتوالى دائماً في فرنسا، مناسبة لاستعراض وتكرار كل أنواع المقولات الثقافية والأيديولوجية الدارجة في زمننا، فسواء تعلق الأمر باحتجاجات عمالية ونقابية وطلابية؛ اضطرابات وأعمال عنف وعمليات إرهابية؛ قضايا الهجرة والاندماج والعنصرية وتجاوزات أجهزة السلطة؛ صدامات على أسس الثقافة وأنماط الحياة؛ التعامل مع قضايا التاريخ والعلمنة والمركزية وبناء الدولة الحديثة، فإن فرنسا هي الهدف الأسهل للنقد السائد: إنها الدولة المركزية الصلبة، المتبنية لـ«العلمانية المتطرفة» التي لا تبذل جهداً لـ«الاعتراف» بأقلياتها، بكل ما لديها من حساسيات ثقافية وعقد تاريخية؛ ولا تتخلى عن عقليتها وممارساتها الاستعمارية؛ أو تجري «إصلاحات» اقتصادية شاملة، تلك الجمهورية نقيض الصواب، رغم محاولة كثير من أبنائها، المنفتحين على «العالم» لجعلها أكثر «صوابية».
لهذا فإن اضطرابات الضواحي الأخير تُصنف عادة بوصفها مشكلة فرنسية، تُناقش عبر استدعاء التاريخ السياسي والاجتماعي المعقد للبلد، وهو تفكير لا غنىً عنه بالتأكيد، لكن الاقتصار عليه قد يُسقط بعض الأسئلة شديدة الأهمية: هل فرنسا وحدها من يعاني من مشكلة «الضواحي»؟ ما الضواحي فعلاً؟ ومن يسكنها؟ هل ستنتهي المشكلة إذا تم تطبيق نماذج «الاعتراف» و«التعددية الثقافية» الأنكلوساكسونية في البلد؟
كل بلدان العالم تعاني بالتأكيد من مشاكل في بناها الاجتماعية، وأنماط نموها الحضري، وتاريخها على مستوى العلاقات الدولية، ما يخلف أزمات لا حصر لها، وانفجاراً دائماً للعنف، إلا أن الانفجارات الاجتماعية الفرنسية ذات صدى عالمي أكبر. قد لا يكون السبب عدم «اعتراف» الفرنسيين بمشاكلهم، بل العكس هو الصحيح، ربما كان الجدل الاجتماعي في ذلك البلد أكثر صراحةً وانفتاحاً وحريةً من الحد المسموح به في كثير من البلدان الأخرى. فضلاً عن ذلك فإن «الخصوصية الثقافية» الفرنسية أتاحت مساحة أكبر لنقد كل تقليد مترسخ، سواء كان قديماً أو حديثاً؛ تراثياً، أو مرتبطاً بـ»الجمهوريات» التي تسقط، ثم تعود لتجديد نفسها. لا توجد «جماعات ضغط» ذات نفوذ غير محدود في فرنسا، ولا «صناعة ترفيه» قادرة على فرض مزاج شبه أحادي على متلقيها، ولا شركات تكنولوجيا بالغة الضخامة، قادرة على التحكم في «التريند». ولذلك قد يكون الصراع والجدل الاجتماعي في ذلك البلد أقدر على جعلنا نفهم شروط تمدننا المعاصرة بأسلوب أكثر انفتاحاً، وطرح الأسئلة بشكل أوضح: من هم سكان الضواحي، الذين يتكلم عنهم الجميع، ويتعاطفون مع مظلمتهم؟ ولماذا يدون الأكثر إثارة للضجيج، في زمن تكثر فيه الأزمات والكوارث؟
الفارق الهوياتي
توجد مشكلة منطقية كبيرة في مقولة «التهميش» بعد أن أصبحت سائدة: عندما تكون مظالمك في صدارة الجدل الاجتماعي، فلا يمكن أن تكون «مهمشاً» أنت في هذه الحالة فاعل اجتماعي أساسي، لك موقع مهم في النزاعات العمومية، حول كل ما يعتبر قضايا حيوية، مثل الموارد والخطاب والقوانين والتمثيل السياسي والمؤسساتي. وعندما يدور الجدل منذ سنوات طويلة، في بلدان «مركزية» مثل فرنسا وأمريكا، عن قضايا «المهمشين» فأصحاب تلك القضايا لن يكونوا مهمشين إلا في حالة واحدة، هي أن لا يكونوا هم المتحدثين، بل هنالك من يتكلم عنهم بوصفهم «آخر» مُعرفاً بآخريته، وبالتالي فإن شرط قدرتك على الحديث عن «مهمش» هو أن لا تكون أنت كذلك، وأن يكون خطابك يستبطن «فارقاً هوياتياً» عمن تتكلم عنه. إنه «الموجود هناك» وليس «هنا» من لا يستطيع الممارسة السياسية وإنشاء الخطاب وإيصال المطالب، وأنت «تترجم» فعله وصراخه، تحت اللغوي، إلى اللغة المفهومة والمقبولة في متن المجتمع. هل يمكن لـ»المهمش» أن يتكلم؟ بالتأكيد لا، «نحن» فقط من يتكلم. بهذا المعنى فإن نقد نظرية «التهميش» ليس نقداً للبشر، الذين من المفترض أنهم يعانون من الظلم والاضطهاد، بل نقداً للأيديولوجيا السائدة، التي عينتهم وعرفتهم بتلك الصفة، مهما كانت «متعاطفة» معهم. يمكن لناشط «أبيض» صحافي في منشورات «المينستريم» أستاذ أو طالب في أكاديمية معترف بها، أن يتحدث كثيراً عن ذلك «الآخر» المستعصي على الدمج، الفاقد للامتياز، في سياق يبدو أقرب لـ»غسيل» امتياز المتكلم. يمكن اقتراح أمر مختلف: الحديث عن مشكلة «الضواحي» ليس بوصفها مشكلة «آخر» يتوجب تفهمه، بل مشكلتنا «نحن» التي يتوجب علينا مواجهتها. وعندها يصبح السؤال: مَن نحن فعلاً؟ بعبارة أخرى، مَن أولئك الذين لا يقدرون على إنتاج خطاب سياسي للتعبير عن أزماتهم، والمطالبة بحلها؟ من يجدون أنفسهم متأثرين بمزيج من الخطابات المتطرفة والليبرالية الجديدة في الآن ذاته؟ من لا يقدرون على السلوك وفق أنظمة اجتماعية وسياسية وقانونية مستقرة، ما يدفعهم إلى الخروج عليها، لدرجة تصل أحياناً إلى الشغب والفوضى ومواجهة احتكار الدولة للعنف؟ هكذا فقط يمكن تجاوز «الفارق الهوياتي» الذي لا تقتصر أضراره على العجز عن التفسير الفعلي، وإنما أيضاً على نوع من «حيونة» كل احتجاج: يمارس أولئك «المهمشون» كل ذلك العنف لأنهم لا يملكون وعياً ومسؤولية مثلنا، هم لا يقومون إلا بـ«رد فعل».
بعيداً عن تناقض الخطاب السائد، يمكن القول إن العنف الاجتماعي والسلطوي، واضطرابات «الضواحي» هي من سمات العصر الحالي، سواء في بلدان ذات ماضٍ كولونيالي، أو غير كولونيالي. كثير من البشر يجدون أن قنوات إدارة التواصل والنزاع الاجتماعي لم تعد تتسع لهم، فيتصرفون بأسلوب يبدو منزوع التحضر، لأن «المؤسسات الوسيطة» مثل الأحزاب والنقابات ومؤسسات التأهيل الرعاية الاجتماعية، لم تعد قادرة على دمجهم في إطار سياسي ومدني وإنتاجي متين. في العالم العربي هنالك الحروب الأهلية؛ في فرنسا وأوروبا اضطرابات وإجرام «الضواحي»؛ أما في الولايات المتحدة فتسود المعازل والتوترات العرقية. في ما مضى كان العمال من أصول شمال افريقية وأبناؤهم جزءاً من «الحزام الأحمر» حول باريس وغيرها من المدن؛ أو مؤسسين لتنظيمات، لعبت دوراً مهماً في تاريخ التحرر الوطني، مثل حزب «نجم شمال افريقيا» اليوم لا يدون، ولا نبدو، إلا ظاهرة من ظواهر «نزع التحضر». ليس السبب بالتأكيد أن «المهاجرين» أرادوا الانتقام العشوائي الآن، وفي الجيل الرابع، من «الماضي الكولونيالي».
أين تقع الضواحي؟
يبدو مصطلح «الضواحي» فاقداً لكثير من دلالاته، فهو ينتمي إلى زمن كان النمو الحضري فيه قائماً على مركز بورجوازي، يجمع في مساحاته كل مؤسسات السلطة والمناطق الاستهلاكية الأرقى، وحوله ضواحٍ محرومة من الخدمات، غالباً ما تكون أحياءً عمالية، أو استطالات عشوائية للمدينة، يشيدها المهاجرون من الأطراف الريفية وشبه الريفية. يمكن لأي متجول في مدينة فرنسية، أو أوروبية معاصرة، أن يدرك خطأ هذا التصور. ما يسمى بـ«الضواحي» ليس بعيداً جداً عن المركز الإداري والاقتصادي والسياحي للمدن؛ ليس محروماً من الخدمات، بل ربما فيه مراكز رعاية، من ملاعب ومكتبات ومدارس، أكثر مما يوجد في الأحياء المركزية والمترفة؛ وفيه طبعاً كثير من المتاجر و«المولات»؛ وبالتأكيد ليس عشوائياً، فعمرانه منظم بدقة. «الضاحية» هي المدينة الأوروبية المعاصرة نفسها، بكل ما عرفته من تغيرات على المستويات الإنتاجية والسياسية والثقافية، يعيش بها بشر فقدوا قدرتهم الفعلية على التواصل، بعد أن تحول كل ما يمكن اعتباره «مساحة عامة» إلى دوائر سحرية منفصلة، قائمة على نمط الحياة والخصوصية والجاذبية الاستثمارية. ربما كان أهم سؤال يطرحه العنصريون في زمننا: كيف يحتجز هؤلاء البشر، الذين لا فائدة منهم، تلك المساحات المهمة في قلب المدن؟ فيما تبدو أعمال الشغب أقرب للتأكيد على وجود وبقاء «من لا فائدة لهم» في قلب المدينة، بل قدرتهم على تشويه وجهها الجذاب. قلب المدينة بات نقيضها، نتيجة سياسات التطوير الحضري في العقود الماضية، وربما كانت «الضواحي» الفعلية هي الأحياء الجديدة، التي يلجأ إليها أصحاب الدخل الأعلى، للهروب من كل الاضطراب والفوضى المدينية الحالية.
من نحن؟
بهذا المعنى فـ«أبناء الضواحي» ليسوا العرب أو المسلمين أو الجزائريين، فهؤلاء موجودون في كل مكان في فرنسا وأوروبا، وتختلف أوضاعهم وآراؤهم وتوجهاتهم، بل هم الشتات المديني الجديد، المتنوع عرقياً وثقافياً، كثيرٌ منهم بالطبع «مهاجرون» لكن مع انزياح مهم في معنى «الهجرة»: من ليس لديه ملكية فعلية في الفضاء المديني المستجد هو «مهاجر» بالضرورة، لأنه سيبقى مترحلاً بين الأمكنة والخطابات والدلالات، خاصةً أن فاقدي الملكية في عصرنا لا يجدون أي هياكل اجتماعية أو سياسية، قادرة على «توطينهم».
تتخذ الاضطرابات طابعاً عرقياً، وثقافياً، وطبقياً، وعصبوياً بالتأكيد، بل يمكن أن تجد فيها كل الاحتمالات، وجميع أنواع «الاختلافات» فعندما تفقد المدن هياكلها، وتتحول بذاتها إلى نقيضها، تفقد صراعتها الدلالة الراسخة، ويمكن لأي علامة ثقافية وسياسية، منزوعة من سياقها، أن تتخذ مركز الصدارة مؤقتاً، وربما تكون تلك «الفوضى» السمة السائدة لصراعات عصرنا، صراعتنا «نحن».
كاتب سوري
القدس العربي