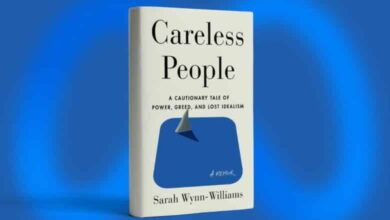سنان أنطون يجعل الحلم الأميركي كابوسا عراقيا/ كاتيا الطويل

في رواية “خزامى” يفقد الطبيب المهاجر ذاكرته ويعاني الشاب الهارب هاجس أذنه التي قطعها النظام
لا تختلف رواية الكاتب العراقي سنان أنطون الجديدة “خُزامى” (منشورات الجمل، 2023)، عن رواياته السابقة وأجوائها، لا سيما من ناحية العلاقة بالعراق والذاكرة والهجرة واللجوء والوجع الإنساني. والرواية هي الخامسة له بعد “إعجام” (2004)، و”وحدها شجرة الرمان” (2010)، و”يا مريم” (2012)، و”فهرس” (2016). ولئن كان الحلم “الأميركي” (اميريكان دريم) أو الوعد بالديمقراطية والحرية والسعادة هو الحلم الذي يرافق كل مهاجر إلى الولايات المتحدة، فإن أبطال سنان أنطون يجدون أنفسهم في “الكابوس” الأميركي أو “الكابوس” العراقي الذي حملوه معهم ولم يستطيعوا أن يخرجوا منه، وهو “كابوس” يتوزع بين طغيان الحكم البعثي وعسكريته، وما أعقبه من ثم من طغيان سلطات الاحتلال والأصولية الجديدة. وبدلاً من تحقيق حياة أفضل، يفقد أحدهما ذاكرته بينما يفقد الثاني هويته وانتماءه. وبما أن أسطورة “الحلم” الأميركي تقول بالعدالة والمساواة والمؤاخاة بين الأقليات، يكتشف أبطال سنان أنطون، بخاصة بعد أحداث سبتمبر (أيلول) 2001 وسقوط البرجين أن الحلم الأميركي إنما هو حلم بعيد المنال لأولئك الهاربين من جحيم العراق.
يكتشف قارئ “خزامى” كذلك أن الكاتب قد نصب له فخاً منذ العنوان. فبدلاً من أن يقع على رواية حافلة بالورد والعطر والربيع المشرق، تتجلى “خزامى” بصفتها رواية الفقد والوجع والهرب، رواية التوجس الدائم من القسوة والوحشية والعنف. فبينما يهرب أحد الأبطال من بطش النظام، يهرب الثاني مما أتى بعد انهيار النظام، ليكون الأمل مفقوداً في الحالين وعلى مختلف الأصعدة. فلا النظام رؤوف عادل ولا ما أتى بعده. فيبقى السؤال الأصح والأجمل في هذا العمل هو حول الوطن والعلاقة به وإمكان المصالحة معه. فيقول الكاتب على لسان إحدى شخصياته: “وطن. كم مرة قرأ هذه المفردة وسمعها في الأغاني الوطنية والقصائد التي أُجبِر على حفظها في المدرسة، وفي نشرات الأخبار والبيانات والخطابات الزاعقة. ولم يفهمها ولن. مفردة رثة”. (ص30).

غلاف الكتاب
يقوم السرد في هذه الرواية على قصتين اثنتين تسيران وفق خطين متوازيين يلتقيان في النهاية بخاتمة مفاجئة ومحنكة، تُظهر براعة أنطون التي لا جدال حولها. وكل قصة من القصتين لها بطلها وظروفه ومأساته. فيفتتح سنان أنطون سرده بشخصية سامي: رجل عراقي متقدم في السن، طبيب أنيق محترم خسر شقيقه وزوجته وبغداد بالصورة التي كان يعرفها عليها. لكن سامي الذي فر من بغداد إلى بروكلين ليقيم مع ابنه وعائلته، فرت منه ذاكرته. وبفقدان المكان الأم، فقد سامي ذاكرته وماضيه ووجوده. بات رجلاً هائماً على وجهه يبحث عن بغداده، عن بيته، هو الذي ما فتئ يسير في الشوارع يطلب من الناس أن يدلوه على بيته، أما عندما يحاولون إعادته إلى بيت ابنه فيرفض، فبيته كان ولا يزال في بغداد وحدها.
أما عمر الشاب الهارب من وحشية نظام صدام فقصته مختلفة وعلاقته بالمكان أكثر وحشية. إن عمر اختار بنفسه أن يفقد ذاكرته. اختار أن يفقد هويته وانتماءه وماضيه. اختار أن يتحول إلى “أومار” من بورتوريكو بدلاً من عمر من بغداد الذي تعرض للتشويه والتعذيب وصلم الأذن لهربه من الجيش. وصلم الأذن أو قطعها هي عادة أو قانون بعثي “صدامي” سُن عام 1993 لمعاقبة من يتخلف عن الخدمة العسكرية. وبينما يسعى عمر لترميم أذنه وإعادتها إلى ما كانت عليه، تبقى جروح الروح بلا شفاء. فيقول: “أصبح الصراخ داخلياً، وأكثر إيلاماً، لأنه ظل محبوساً، مثله. وحتى بعد أن أطلِق سراحه هو، ظل الصراخ المكتوم في دواخله. صراخ لا يمكن ترويضه، ولا ترجمته إلى بكاء يخفف من وطأته”. (ص136).
إن العلاقة بالوطن تتجلى في هذه الرواية علاقة وجع ويأس وعنف. فالقصتان تنتميان لبطلين مختلفين تمام الاختلاف، وقادمين من مجتمعين مختلفين وجيلين مختلفين وبيئتين مختلفتين. الشاب والعجوز هاربان، الثري والفقير هاربان، الداعم للنظام والكاره له هاربان. إنما ما حقيقة الهرب من المكان؟ وهل ينتهي؟
الذكريات والحاضر
يبدو أن لعنة العراقي هي أن يبقى تائهاً هارباً، فحتى في أرض الحلم الأميركي تاه سامي بين الحاضر والماضي، فقد ذاكرته وماضيه وظل يبحث عن بيته المفقود. أما عمر فقد تاه هو الآخر بين الولايات والوجوه والقصص، فهل هو عمر أم أومار؟ كيف يحمي نفسه من الأحكام المسبقة على العراقيين وعلى المسلمين وعلى اللاجئين بعد أحداث سبتمبر 2001؟
تبقى العلاقة بين الماضي والمستقبل هي الخيط السردي الأذكى الذي نسجه سنان أنطون، خيط الربط بين سامي وعمر، بين بغداد الطبيب وبغداد الشاب الهارب من خدمة الجيش، فكيف سيلتقي الرجلان في بلاد بعيدة هربا إليها من ماضيهما، من دون أن يكف الماضي أذاه عنهما؟
يبدو جلياً في هذا النص أن الهرب من المكان إنما هو الموضوع الأول. لكن المكان يسكن الذكريات ويسكن الإنسان بطريقة أو بأخرى، إما بغيابه القاسي عبر مرض الخرف لدى سامي وإما بحضوره الأقسى في كل كلمة وكل نظرة وكل حركة لدى عمر. يكون الهرب هو أساس السرد ومحركه، الهرب من وحشية الإنسان ودمويته وقسوته، فيكتب سنان أنطون: “كل علوم الأرض لن تفسر لماذا يتفانى كثر […] في محق بعضهم بعضاً. الأرض التي تبدو ألا راحة كاملة إلا تحت ترابها”. (ص53).
أما الوجع فلا يزول. يحمله المرء علامة على جسده في حالة عمر، أو علامة في ذهنه في حالة سامي. الوجع من بغداد ومن أهلها ومن الأحلام التي تحطمت على قدميها، كأن تقول إحدى الشخصيتين بلهجة عراقية منهزمة وثلاث مرات متكررة: “كلشي انـﮔضى”. (ص128). كل شيء انقضى.
ثنائية اللغة
تقوم رواية “خزامى” على ثنائيات كثيرة، منها المتعارض ومنها المتعاضد. فمن ثنائية السرد القائمة على قصتين وبطلين، وثنائية المكان المتأرجحة بين بغداد الأم وأرض المهجر، وثنائية الزمان القائمة على عودات إلى الوراء ثم قفزات إلى الحاضر، يصل الأمر بسنان أنطون حد خلق ثنائية على مستوى اللغة، وهو أمر معروف عنه في رواياته السابقة. فأنطون لا يخشى دخول فضاء اللهجات المحلية واعتمادها في الحوارات الموجودة في سرده. فالعراقية موجودة واللبنانية واليمنية وغيرها، الإنكليزية نفسها هنا، تدخل السرد إلى جانب اللغة العربية الفصحى السلسلة التي يعتمدها أنطون في سرده. وهذه التقنية اللغوية في السرد لافتة في أدب أنطون منذ رواياته السابقة، وهي نوع من بصمة خاصة به، فهو لا يتوانى في إيراد اللهجات المحلية لكل شخصية بما يتناسب معها ومع تاريخها، حتى وإن أكثر منها في أحيان. حتى أنه يورد أغاني شعبية وأبيات شعر وكل ما قد يخطر ببال أو يوافق الفضاء السردي المنسوج.
تبقى كذلك مسألة الثنائية في الضمائر. يقع القارئ في مواضع قليلة من السرد على سرد بصيغة ضمير المتكلم “أنا”. وعلى أن السرد بأكمله قائم على توظيف ضمير الغائب “هو”، تظهر هذه المقتطفات الصغيرة والمتفرقة لافتة وغريبة. صحيح أنها غير متوقعة وتثير الريبة والتوجس في ذهن القارئ، إنما الكاتب على ما يبدو، أرادها لتعزز الشعور بالتيه والضياع. فالسرد نفسه، مرة يكون بضمير “هو” ومرة بضمير “أنا”.
“خُزامى” رواية سنان أنطون الخامسة، هي رواية العجز والوجع والذكريات، رواية بغداد والهرب منها ولكن البقاء داخل سجنها إلى الأبد. هي رواية الحواس التي تسكن الشخصيات وتمنعها عن المضي قدماً. الموسيقى تعيد إلى بغداد، والرائحة تعيد إلى بغداد، والخزامى تعيد إلى بغداد، والمذاق يعيد إلى بغداد. كل حاسة من حواس الشخصيات تحملها إلى تلك البلاد البعيدة المحبوبة والمرعبة في الآن نفسه. تلك البلاد التي لم يأخذ أحد منها شيئاً بينما أخذت هي كل شيء.