اللغة والتطرف في أوروبا
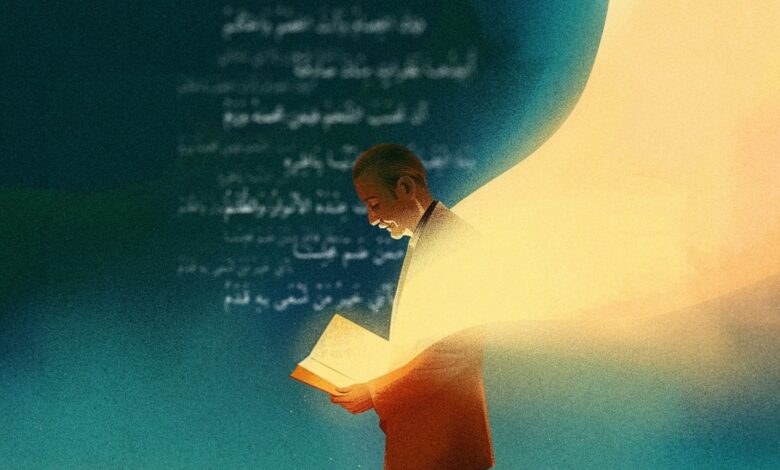
26 مارس 2024
في ظلّ غياب الأطر المؤسساتية الواضحة التي يمكن أن يقوم عليها تعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات العربية المنتشرة في العديد من دول أوروبا، فقد ظلّت هذه العملية مرهونة خلال عقود خلت، وصولا إلى زمن الهجرات الجديدة، بطابع ديني يضع اللغة العربية في صلب التكوين الثقافي والسياسي لتلك المجموعات، وهو يشكّل أحد أدوات جماعات الإسلام السياسي، لتسهيل وصول أيديولوجياتها إلى الشباب واستقطابهم. “المجلة” تطرح عبر سلسلة مقالات واقع اللغة العربية وتعليمها في أوروبا.
* العربية في ألمانيا…أتتحرّر من “الإخوانية”؟ – محمد أبي سمرا
* العربية في هولندا: أسلمة اللغة والتقاليد السابقة للمهاجرين – هدى العطاس ورنوة العمصي
* العربية في فرنسا بين تطرّفين :الإسلاموية والإسلاموفوبيا – صبر درويش
* هنادا طه: فشلُنا في صناعة المعلّم معضلة العربية المزمنة – محمد أبي سمرا
* ترجمة النصوص المقدّسة: جسور بين الثقافات أم جدران عازلة؟ – سامر أبوهواش
———————-
العربية في ألمانيا…أتتحرّر من “الإخوانية”؟/ محمد أبي سمرا
طغت على تعلّم وتعليم العربية، بل ابتلعتهما مسألة/ معضلة أكبر منهما بكثير، وأرّقت وتؤرق الحكومة والمجتمع.
آخر تحديث 24 مارس 2024
تبدو مسألة تعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات العربية المقيمة في ألمانيا وأطفالها، ضعيفة الحضور في الحياة العامة والتربوية الألمانية، منذ نهاية خمسينات القرن العشرين حتى اليوم. لكن موجة اللجوء السورية الضخمة التي حطت رحالها في ألمانيا، حرّكت المسألة الراكدة والملتبسة بتعليم الدين الإسلامي، ونشّطتها، لكن في سعي لإدراجها في أطار منفصل عنه. قبل الموجة السورية كانت الجاليات العربية في ألمانيا مصرية ومغربية وفلسطينية وعراقية ولبنانية. لكنها كانت صغيرة أو ضئيلة الأعداد ومشتتة، مقارنة بالجالية التركية الأقدم زمنا في وفادتها، والقوية والكثيفة الحضور في البلاد الألمانية: يتجاوز عديدها 3 ملايين نسمة اليوم، وبدأ حلولها في ألمانيا في خمسينات القرن العشرين، بناء على عقود عمل موقتة. أما جالية اللجوء السورية والهجرة قبلها، فيبلغ عددها نحو مليون ونصف المليون نسمة.
العربية والإسلام التركي
طغت على تعلّم وتعليم العربية في ألمانيا، بل ابتلعتهما مسألة/ معضلة أكبر منهما بكثير، وأرّقت وتؤرق الحكومة والمجتمع الألمانيين: حضور الدين الإسلامي والتربية الإسلامية في المساجد والجمعيات التابعة لها، وفي مدارس خاصة تدمج تعليم الدين بالعلم. وبما أن الجالية التركية تتصدّر المشهد الإسلامي في ألمانيا، لأنها أقدم عهدا بكثير من السورية الحديثة زمنا، وأقوى حضورا وتماسكا من سائر مثيلاتها العربيات، انشغلت ألمانيا بالإسلام التركي. وهذا منذ مطلع الألفية الثالثة، بل منذ التسعينات، حتى اليوم، وبعدما كان إسلام الأتراك المهاجرين في سائر دول أوروبا إسلاما تقليديا خافتا أو ذاويا خلف صلابة القومية التركية الكمالية. لكنه استفاق وصار حيا، وسياسيا فاعلا، منذ تصاعد قوة “حزب العدالة والتنمية” الإخواني التركي، وخروجه خروجا سلسا عن الكمالية العلمانية المتشددة، وصوغه القومية التركية صوغا جديدا، جعلها قومية تركية إسلامية، أثناء صعوده إلى سدة السلطة والحكم في تركيا التي صارت أردوغانية، بعدما كانت كمالية.
في الأثناء، أي منذ العام 2000 حتى اليوم، صارت الجالية التركية في ألمانيا إسلامية قومية، ومرتبطة عضويا بقيادة وسياسات “حزب العدالة والتنمية”. وهذا ما يؤرق الحكومة والمجتمع الألمانيين من الإسلام عامة، والتركي منه على وجه الخصوص، ليس لأنه إسلام ديني واجتماعي وثقافي، بل لأنه سياسي ومرتبط بدولة خارجية ترعاه وتديره وتوجهه سياسيا في ألمانيا، ولو على نحو مسالم بلا عنف.
أما الإسلام العربي اللسان واللغة والثقافة، قبل الموجة السورية الضخمة، فكان إسلاما مصريا إخوانيا، ويخالطه إسلام مغربي، وتعود بداياته إلى أواخر الخمسينات، حينما شن النظام المصري الناصري حملته العنيفة على جماعة الإخوان المسلمين، فهاجر شطر منهم أو فرَّ إلى أوروبا، حيث أسسوا خلايا تنظيم الإخوان الدولي بين ألمانيا والنمسا وبريطانيا. وفي ألمانيا اختلط إسلاميون مغاربة بالإخوان المصريين، الذين اختلطوا لاحقا بالإسلام الإخواني التركي، القوي والواسع.
إمام صُنع في ألمانيا
نورد هذه الخريطة السريعة والجزئية للإسلام في ألمانيا، مقدمة ضرورية لعرض حال المهاجرين العرب هناك مع لغتهم الأم العربية. وهذا للإشارة إلى أن مسألة الإسلام، بوصفه دين عقيدة اجتماعية – سياسية، هي التي تصدرت التعريف بالهجرة والمهاجرين المسلمين، فوق تعدد أقوامهم ولغاتهم. وكذلك بمشكلاتها (الهجرة) ومشكلاتهم، مما أدى إلى إزاحة مسألة لغاتهم وعلاقتهم بلغاتهم الأم إلى الهامش. لكن اتساع حضور الإسلام التركي وقدرته على التنظيم، حمل ألمانيا على إدراج اللغة التركية، شأن الروسية، في برامج تعليم مدارسها الرسمية، من دون أن تدرج اللغة العربية في تلك البرامج، بسبب قلة أعداد الجاليات العربية وقدرتها على التنظيم وتفرقها، قبل موجة اللجوء السوري الكبيرة.
أما الدستور الألماني الاتحادي فيكفل، في ألمانيا الفيديرالية كلها، مبدأ حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية كافة وللجميع. لكن الإسلام التركي الضخم والقوي اجتماعيا، الذي باشرت جمعياته ومنظماته ومؤسساته الناشطة بناء مساجد في مدن ومقاطعات ألمانية كثيرة، وحولتها مقارّ لدروس دينية ونشاط دعوي إسلامي، حمل الحكومة الألمانية على التدخل في تلك الأنشطة المساجدية لتنظيمها، والحد من فوضاها.
كانت تلك الأنشطة قد بدأت في العام 1984، ونجم عنها تأسيس “الاتحاد الإسلامي للشؤون الدينية” التركي، المعروف بـ”ديتيب” اختصارا. وقد جاءت ولادته في مدينة كولن بمقاطعة وستفاليا شمال الراين، كبرى المقاطعات الألمانية وأكثرها سكانا – 15 مليون نسمة من أصل 82 مليون نسمة، إجمالي سكان ألمانيا – وأعداد مهاجرين. وسرعان ما كبر “الاتحاد الإسلامي” وتوسع نشاطه، فصار يضم 930 جمعية ويدير 900 مسجد في الولايات الألمانية الـ 16. حدث ذلك بعد العام 2000، بتمويل من تركيا “حزب العدالة والتنمية”، وبأئمة مساجد درّبهم وموّلهم الحزب إياه. فالاتحاد يتبع مباشرة هيئة الشؤون الدينية (ديانت) في تركيا. ويقول ألمان كثيرون عارفون إنه تابع مباشرة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتضاعف بين العامين 2000 و2015 بناء المساجد، صغيرها (نحو 3 آلاف مسجد) وكبيرها (230 مسجدا) في البلاد الألمانية. وسرعان ما تنبهت السلطات الألمانية إلى فوضى كبيرة تلابس إدارة هذه المساجد، إذ خلّف “الاتحاد” الجامع هيئات وجمعيات متنافسة ومتضاربة التوجهات والمذاهب الدينية، في تدريسها القرآن والشريعة والتربية الإسلاميتين، باللغة التركية غالبا، وليس بالألمانية، وعلى نحو محدود بالعربية، حسب حضور بعض أبناء جالياتها ومساهمتهم في نشاط المساجد. لكن هذا غالبا ما ينطوي على منافسة ومنازعات، لأن القيمين على شؤون التعليم تلك، إلى جانب أئمة المساجد، يتحدّرون من أصول تركية في معظمهم.
تحت عنوان تنظيم شؤون الإسلام، وضعت حكومات الولايات الألمانية، برامج شعارها “إمام صُنع في ألمانيا”، وغايتها إعداد أئمة مساجد بمناهج مدروسة تضعها هيئاتها التربوية، لتدريس التربية الإسلامية في المدارس الألمانية الرسمية، بمراحلها كافة وباللغة الألمانية. وذلك كي لا تترك الأمر للفوضى والنزاعات الدائرة بين الجمعيات الإسلامية على إدارة المساجد. هكذا صارت حكومات الولايات تشرف مباشرة على إعداد أئمة المساجد، ثقافيا ومهنيا، كما على برامج تدريس التربية الإسلامية.
عربية المنزل والمدارس الخاصة
خلف هذا المشهد الإسلامي الطاغي على أوضاع الجاليات المهاجرة في ألمانيا قبل موجة الهجرة السورية الكبيرة، اختفت مسألة تعليم أبناء المهاجرين العرب لغتهم الأم. أما السوريون فقد انهمكوا، في السنوات الأولى من حلولهم في ألمانيا، بتدبير شؤون حياتهم الجديدة: تعلّم اللغة الألمانية، والانخراط في دورات تدريب مهني. وهما تستغرقان بين سنوات ثلاث وأربع، والشرط الضروري لحصولهم على إقامة دائمة والدخول إلى سوق العمل. ومن لديهم أطفال منهم، سجلوهم في المدارس الألمانية الرسمية التي كانت قد بدأت تدرّس التربية الإسلامية باللغة الألمانية، حصة واحدة في الأسبوع لمن يرغب ويشاء من تلامذتها المسلمين.
تشير الإحصاءات الألمانية إلى أن غالبية اللاجئين السوريين من الشباب. ومتوسط أعمارهم 24 سنة. 70 في المئة منهم ذكور. ونسبة العازبين 58 في المئة. المتزوجون نسبتهم 31 في المئة. معظمهم حصل على تعليم ثانوي (71 في المئة). 44 في المئة منهم يتحدثون الإنكليزية بإتقان. وبعد سنوات قليلة بلغت نسبة المتحدثين بالألمانية بينهم، 56 في المئة. و80 في المئة منهم يعتزمون البقاء الدائم في ألمانيا.
تبين هذه الأرقام أن الجالية السورية في ألمانيا معظمها من المتعلمين الجاهزين للانخراط في المجتمع الجديد والاندراج في سوق العمل. الكاتبة السورية رشا عباس التي التقتها “المجلة” في برلين حيث تقيم، قالت إن كثرة من الكتاب والمثقفين السوريين عزفوا عن تعلم الألمانية، لأنهم يجيدون الإنكليزية التي تعتبر لغة ثانية وأساسية في ألمانيا، وتمكنهم من التواصل والعمل في الدوائر والأوساط التي يحتكون بها. أما مسألة تعليمهم أطفالهم لغتهم الأم، فقد تأخر بروزها في أوساطهم إلى ما بعد إنجازهم شكلا من أشكال الاستقرار، وتنبُّههم إلى أن المدارس الرسمية الألمانية لا تدرج تعليم اللغة العربية في برامجها التربوية، أسوة بالتركية والروسية مثلا. لذا بدأوا، كسواهم من المهاجرين السابقين، البحث عن طرق ووسائل لتعليمهم العربية، فلم يجدوا لذلك مكانا – غير المنزل الذي يعتمدون فيه على أنفسهم – إلا المساجد ومراكز الجمعيات الإسلامية.
شاب سوري متزوج من ألمانية من أصل فلسطيني في برلين، ولديهما طفل في السابعة من عمره، قال إنه فتش عن مدرسة خاصة لتعليم طفله العربية، بعدما اكتشف ارتباط تعليمها في المساجد ومراكز الجمعيات، بالدين الإسلامي وقراءة القرآن. وحين تعرف إلى امرأة سورية سبقته في الهجرة وأنشأت مدرسة خاصة في الحي الذي تقيم فيه ببرلين، وجد أن المدرسة غرفة واحدة يتعلم فيها 5-4 أطفال ساعة أو اثنتين في عطلة نهاية الأسبوع. وبعد تردد ابن الشاب السوري مرات على تلك المدرسة – الغرفة، قال لوالديه إنه غير راغب في تعلم العربية. لذا اتفق الزوجان على أن يكون المنزل مكان تعلّم طفلهما لغة والديه الأم: والده يكلمه بالعربية، وأمه بالألمانية. وهكذا أخذ الابن الصغير يتكلم عربية مكسرة، ولا يرتاح أثناء نطقه كلماتها، فيما يستدرجه والده إلى الكلام بها.
مدارس الدين والعربية
روى مدرّس لغة عربية في مدرسة خاصة ببرلين، وهو مغربي الأصل، أن المدرسة احتفلت في 21 فبراير/شباط 2023 بــ “اليوم العالمي للغة الأم”. فدعت أهالي تلامذتها وسواهم من معارفهم إلى المشاركة في الاحتفال. المدرسة قديمة نسبيا، ويعود إنشاؤها إلى العام 2005، تجاوبا مع تزايد طلب الجاليات العربية البرلينية على تعليم أولادهم لغتهم الأم، خوفا عليهم من أن يكبروا ويغتربوا عنها تماما، بعدما دارت على ألسنتهم في حياتهم البيتية. لكن المدرس المغربي الأصل – وهو رئيس نادٍ لدعم اللغة العربية – علّل ذلك الخوف بـ”حنين الأهل إلى بلدانهم الأولى، وإلى ذكرياتهم فيها”. أما هو، المدرس، فيرى أن تعلّم العربية غايته “الترابط الأسري والعائلي، وحفظ القرآن، وممارسة الشعائر الدينية”، معتبرا أن “العربية والإسلام واحد لا تنفصم عراه”. ولدى سؤالنا إياه عن الكتب المدرسية العربية المعتمدة في المدرسة، قال إنها أُعدّت وطُبعت في فرنسا.
المدرسة هذه واحدة من مثيلاتها في مدن ألمانية عدة. وهي تعلم التلامذة العربية في عطل نهاية الأسبوع. ومعظمها نشأ بسبب غياب تدريس العربية في المدارس الرسمية الألمانية. وكثرة منها تسمى “مدرسة النور”، وتتبع مساجد بالاسم نفسه. وهي غالبا ما تخصص ساعة لتدريس العربية، وساعتين لمبادئ الدين الإسلامي. والأهل يُحضِرون أطفالهم إلى المدرسة، فيتعارفون ويتحادثون على الرصيف قربها، أو في مقهى قريب، منتظرين انصراف أطفالهم منها.
رجل من منتظري أولادهم في المقهى، قال إن اليمين المتطرف الألماني (أي حزب البديل من أجل ألمانيا) يلتقي مع الإسلاميين في إدانة تدخين “الشيشة”، أي النرجيلة. وقال أيضا إنه يكتفي بتعليم ابنه دروس اللغة العربية فقط في المدرسة القريبة من المسجد، عازفا عن حضوره حصة التربية الدينية وحفظ القرآن. وهو أضاف أنه ينتظر أن تقرر الحكومة الاتحادية الألمانية إدراج تعليم العربية في المدارس الرسمية، كي يقلع عن اصطحاب ابنه إلى مدرسة النور هذه. ذلك أنه قرأ في صحف ألمانية مقالات تدعو إلى ضرورة تعليم العربية في المدارس الرسمية. وهذا علما أن قطاع التعليم الألماني ليس مركزيا في إدارته، ولا من اختصاص الحكومة الفيديرالية وحدها، بل هو من اختصاص كل ولاية على حدة.
مبادرات عربية وألمانية
“تدريس اللغة الأم للمهاجرين يساعد في اندماجهم”، يقرُّ عدد من باحثين في ألمانيا. لكن هذا الرأي يتحفّظ عنه رأي آخر ألماني أيضا: “وحدها الألمانية لغة الاندماج”. ومفهوم الاندماج غالبا ما ينتقده باحثون يرون أن تعدد الثقافات وأنماط العيش واللغات من ضرورات الديمقراطية، ومناهضة التيارات اليمينية المتطرفة المعادية للتنوع والأجانب، وللهجرة والمهاجرين.
مترجمة سورية مقيمة في مدينة أخن، وناشطة في حملة لتعليم أطفال مهاجرين ولاجئين سوريين اللغة العربية، تمهيدا لتأسيس مدرسة خاصة لهذه الغاية، أشارت إلى أن السنوات العشر التي مضت على موجة لجوء السوريين الكبيرة، نبهتهم إلى ضرورة البحث عن سبل لتعليم أطفالهم لغتهم الأم. وتحت عنوان أو شعار “المدرسة بديلا للمسجد” ظهرت في أوساط مهاجرين يقولون إنهم علمانيون، مبادرات عدة يشارك فيها معارفهم من الألمان. وتدعو هذه المبادرات إلى إدراج تعليم العربية في المدارس الألمانية الرسمية، وتعمل في سبيله.
وتحدثت الناشطة والمترجمة السورية عن صديقة لها تونسية في مدينة أسن، أطلقت منصة إلكترونية لتعليم العربية والثقافة الإسلامية على نحوٍ مختلف عن أساليب ومضامين إسلام المساجد. المنصة تمهيد لتأسيس نادٍ ثقافي، من نشاطاته تعليم العربية للأطفال. لكن مثل هذه المبادرات لا تُغني قط عن العمل على دعوة الإدارة التربوية الألمانية إلى إدراج تعليم العربية في المدارس الرسمية، حسب الناشطة السورية.
في مقالة صحافية في القسم العربي لوكالة الأنباء الألمانية “دوتشيفيلة” (D.W) ورد أن “اللغة العربية خرجت من معاهد الإسلاميات الأكاديمية، إلى الشوارع والحياة اليومية في ألمانيا، وصار لها بعض الحضور في سوق العمل”. فبعد برامج لغة الاندماج (الألمانية) ودورات معاهد التعليم المهني للمهاجرين، يجب أن يبدأ التفكير بوضع برامج ومناهج لتعليم اللغة العربية في المدارس الألمانية الرسمية. وهذا بعدما تعالت أصوات فئات واسعة من مهاجرين ولاجئين أصولهم عربية وسورية خصوصا وحازوا الجنسية الألمانية، تطالب بأن يتعلم أطفالهم لغتهم الأم، أسوة بسواهم من أبناء الجاليتين الروسية والتركية، وربما اللاجئين الأوكران الذين استقبلتهم ألمانيا بأعداد كبيرة.
وعدّدت المقالة المبادرات الألمانية التي استجابت عمليا بعض حاجات الجاليات العربية:
• ترجمة الدستور الألماني إلى العربية، وتوزيعه على نطاق واسع في مراكز اللجوء والبلديات ومراكز الخدمات الاجتماعية.
• إصدار بعض الصحف الألمانية طبعات خاصة جزئية باللغة العربية.
• تخصيص برنامج تلفزيوني أسبوعي ناطق بالعربية في عنوان “مرحبا بكم في ألمانيا”، وغايته تعريف المهاجرين واللاجئين بألمانيا ومجتمعها وقوانينها. وأثار هذا البرنامج جدالا في أوساط ألمانية. فالبعض احتج عليه قائلا: “قد نشاهد غدا في التلفزيون الألماني إمام مسجد يتلو القرآن ويرفع الأذان للصلاة!”. لكن هذا الاحتجاج جابهته أوساط ألمانية أخرى بالقول إن ألمانيا بلد تعددي منفتح ومستقبل للثقافات واللغات التي تثريه.
• ومن المبادرات الألمانية التي تعتمد العربية في التواصل، تخصيص إدارة الهجرة واللجوء في الولايات الألمانية خطا هاتفيا ساخنا يستقبل اتصالات غايتها استشارات واستفسارات وإرشادات عائلية من اللاجئين والمهاجرين على مدار 24 ساعة. ويتلقى هذه الاتصالات مرشدون اجتماعيون يجيدون العربية، ومؤهلون في القانون والتربية العائلية.
لا فصل بين العربية والإسلام
لكن في المقابل، أثار وضع لافتة باسم أحد الشوارع بالعربية في مدينة دوسلدورف، عاصمة ولاية وستفاليا الإدارية، تحفّظا في المدينة. وقام نقاش بين المحافظين الذين تحدثوا عن “تعريب ألمانيا”، وسواهم من التيارات المرحبة بالهجرة واللجوء والتعدد الثقافي واللغوي. وغالبا ما تثير المسائل المتعلقة بالإسلام والمسلمين، ومن ضمنها اللغة العربية، نقاشا وانقساما واسعين في ألمانيا. وهذا ما حدث قبل سنوات في مدينة كارلسروه، ثاني أكبر مدينة في مقاطعة بادن بعد شتوتغارت، وعدد سكانها 313 ألف نسمة، وتعدّ مدينة جامعية، ووفدت إليها العمالة التركية منذ ستينات القرن العشرين. وفي العام 1988 توسع فيها نشاط جمعيات إسلامية أنشأت مسجدا سُمي مسجد النور.
وروى لبناني تخرّج في جامعة المدينة، ويعمل اليوم في مدينة كولن حيث التقته “المجلة”، أن مهاجرين مصريين وسودانيين ومغاربة تعاونوا مع أتراك على إنشاء الجمعيات والمسجد الذي راح منشئوه يسمونه “جامعة إسلامية” لتدريس القرآن والفقه، إلى جانب اللغتين التركية والعربية. وبلغ عدد طلاب المسجد في عطل نهاية الأسبوع نحو 500 من أعمار مختلفة، بينهم فتيات محجبات. وسرعان ما نشأت خلافات بين الأتراك والعرب القيمين على المسجد الذي يصلي فيه أيام الجُمَع ما يزيد على 3 آلاف شخص. وأضاف الراوي اللبناني قائلا: لك أن تتخيّل ماذا يمكن أن يحدث في المدينة في هذه الحال التي ساهمت في حمل حكومة الولاية على الإسراع في إقرار مشروع “إمام صُنع في ألمانيا”، الذي أدى إلى تعليم التربية الإسلامية باللغة الألمانية في مدارس الولاية.
زارت “المجلة” مسجد الرسالة في أحد أحياء برلين. ومن تحدثت إليهم من القيمين عليه والعاملين فيه وفي المركز الإسلامي التابع له، لا يفصلون في كلامهم بين تعليم العربية وتعاليم الإسلام. إمام المسجد قال إن “تعليم العربية والإسلام في بيت الله، ينقذ الفتيان من تلقيهم معرفة مشوّهة بدينهم عن الإنترنت”. امرأة سودانية ثلاثينية، قالت إنها تحضر خطب الجمعة في قاعة النساء في المسجد. نهار السبت تصطحب طفلتها لتلقي درس اللغة العربية والدين فيه. شابة أخرى محجبة، وهي من أصل مصري قالت: “علاقتي باللغة العربية علاقة عشق وحب شبه صوفي لجذوري وهويتي وأصالتي وديني”. وسرعان ما تساءلت قائلة: “كيف لي أن أرتاح، فيما أبناء العروبة والإسلام يتكلمون الأعجمية، ويحلمون بلغة لاتينية؟”.
في اتصال هاتفي بإمام وخطيب مسجد مدينة كيل – وهو اشترط إغفال اسمه للإدلاء بشهادته عن عمله في المسجد وفي المركز الإسلامي التابع له – قال إن المركز تأسس في نهاية التسعينات، ويدرّس العربية والتربية الإسلامية بمبادرة من جمعية مهاجرين مغاربة ومصريين، سبقهم مهاجرون أتراك في إنشاء المسجد، وسمحوا لهم لاحقا بتدريس العربية في المركز إلى جانب تعاليم الإسلام.
وحسب إمام المسجد أن “دعوات مجابهة الإسلام والمسلمين تتزايد في ألمانيا”. وهو علّل ذلك بـ “انتشار الإسلام بين الألمان أنفسهم، وبتزايد عدد المساجد التي يفوق عدد زوارها زوار الكنائس الخاوية. وهذا ما ولّد خوفا لدى الألمان على النصرانية”. لكن المفاجأة الكبرى في كلام الإمام جاءت في حديثه عن دراسة ألمانية قال إنه قرأها، وتفيد بأن نحو ألفي شخص ألماني يعتنقون الإسلام سنويا. وهو علّل ذلك بافتتانهم بشعائر الإسلام في الأعياد وصيام رمضان وفي الإفطارات الرمضانية.
تأويل ليبيرالي للدين
في مقابلة صحافية مع الباحثة الألمانية غوردون كريمر، وقد نشرها موقع وكالة “دوتشيفيلة” الألمانية، تحدثت كريمر عن الأهداف والغايات التي انطوى عليها تنفيذ مشروع “إمام صُنع في ألمانيا” الذي يهدف إلى الحدّ من فوضى التعليم الديني في المساجد، بتخريج أئمة يحملون شهادات من معاهد ألمانية عليا تستغرق الدراسة فيها سنتين وفق مناهج عقلانية، وتنتهي بتولّي المتخرجين تدريس التربية الإسلامية باللغة الألمانية في المدارس الرسمية، بإشراف هيئات تربوية وأكاديمية متخصصة.
من الأفكار التي عرضتها كريمر، حاجة المسلمين إلى “تأويل ليبيرالي للدين الإسلامي” ليتمكنوا من تحديد علاقتهم “بالمقولات الواردة في القرآن والسنّة النبوية”. والإقرار بأن القرآن هو كلام الله المنزّل، ولا يمكن تغييره، يجب ألّا يجعل منه “كتاب تعليمات في القانون المدني الدنيوي”. ثم إن على المسلمين اعتبار الإسلام دينا للسلام، بدل المطالبة بالجهاد والحض عليه. وفي إشارة مزدوجة منها حول مشكلة الرسوم الكاريكاتورية الذائعة المسيئة للإسلام والمسلمين، ذكرت أن على المسلمين في مجتمع تعددي أن “يجدوا للإسلام مدخلا يسمح بالشك والسؤال”. لكنها سرعان ما أضافت: “إذا كان لا يتبادر إلى ذهن أحد في ألمانيا أن يتهكم على اليهود أو على المحرقة اليهودية، فيجب اعتماد رهافة وحكمة مماثلة حيال المسلمين”. وهي تساءلت في هذا السياق: “لماذا ولأي غرض يُقال إن على المسلمين تحمّل السخرية في المواضع التي تؤلمهم؟ وهذا في حال كنت أريد كسبهم ودفعهم إلى مراجعة دينهم وتراثهم. لذا ليس من المجدي قط أن استهدف مواضع الألم في وجدانهم مرارا”.
أحد الباحثين من معدّي الكتب المدرسية للتربية الإسلامية، يشرح في المقدمة الأساسية للكتاب التعريفي بمناهج هذه الكتب، مشيرا إلى أنها تعرض القضايا الأساسية في الإسلام، ومنها مفهوم الله والنبي والنبوة، هيكل القرآن الكريم، المسؤولية الاجتماعية، حقوق الإنسان والأطفال. ويذكر أن الهدف من تعليم الدين الإسلامي هو “تكوين نظرة إليه، نقدية وبنّاءة. وتقديم فرصة للطلاب للتفكير في دينهم في سياق الحياة والمجتمع الذي يعيشون فيه. وتزويدهم القدرة على فهم الأحكام الدينية وتقييمها”.
وعن المنهاج المتّبع في تدريس التربية الإسلامية، قال الباحث إنه “تجريبي، ويشجع الطلاب على إقامة مسافة من الفهم الحر والمستقل للدين”، مشددا على ضرورة امتلاك المسلمين حق تعليم أبنائهم تعاليم دينهم بإشراف مؤسسات الدولة، كسواهم من أبناء الديانات الأخرى.
العربية في المدارس الرسمية
وكما أدت تراكمات دامت عقودا من فوضى تعليم الدين واللغة العربية في المساجد ومراكز الجمعيات الإسلامية، إلى إقرار تعليم التربية الإسلامية في المدارس الرسمية الألمانية والشروع فيه، يبدو أن الشروع في إدراج تعليم اللغة العربية في المدارس إياها يسير بخطى سريعة في ألمانيا، وإن على نحو متفاوت على مستوى الولايات. فوزير التربية في حكومة ولاية وستفاليا، نوّه قبل أكثر من سنة بالمبادرات التي تدعو إلى إقرار المشروع “المفيد” في تخليص فوضى تعليم العربية مندمجة بتعاليم الدين الإسلامي في المساجد.
بعض المدارس الرسمية في مدن ألمانية عدة، بادرت فعلا إلى الاستعانة بمدرسي لغة عربية كانوا يدرّسونها في نوادٍ أو مدارس خاصة، فوظفتهم مدرسين فيها. والمدارس هذه استفادت من خبرات هؤلاء، وتعاقدت معهم بعد إجراء دورات تدريبية على المنهاج المدرسي العام. وهذا ما حصل في مدينة مونستر، على سبيل المثل. وفي ولاية سارلاند، تدرس الحكومة منذ العام 2019 خيار تعليم العربية في مدارسها الرسمية، بعدما تزايد عدد اللاجئين فيها، وحاجة 7500 تلميذ إلى تعلّمها.
المترجمة السورية والناشطة في تدريس العربية، التي التقتها “المجلة” في برلين، قالت: “ليس من السهل أن تصبح مدرّسا. صحيح أن عدد المدارس الرسمية التي تدرّس العربية يزداد باضطراد، لكن المسار لا يزال في بدايته. الحكومة الفيديرالية تدرس الأمر، وتقوم ببعض الاختبارات قبل أن تُقدم على تعميم التجربة”.
————————————
العربية في هولندا: أسلمة اللغة والتقاليد السابقة للمهاجرين/ هدى العطاس ورنوة العمصي
قطيعة أبناء المهاجرين الثقافية مع لغة ومواطن أهلهم الأصلية تؤرق فعلا الجيل الأول من المهاجرين العرب والملتحقين في السنوات الأخيرة بقطار الهجرة.
آخر تحديث 24 مارس 2024
لم تعد مسألة تعلّم اللغة العربية وتعليمها لأبناء الجاليات العربية المهاجرة والمتوطنة في أوروبا – وتحديدا في هولندا، حيث جُمِعت مادة هذا التحقيق – تتعلق بجاليات المهاجرين فحسب، بل صارت مسألة سياسية وهوياتية شائكة في المجتمعات الأوروبية كلها تقريبا.
فعلى الرغم من أن هولندا بلد صغير، هادئ وغير مأزوم، والجاليات المهاجرة إليه وفيه والناطقة بالعربية هادئة بدورها وأعدادها ليست ضخمة، ولا يربطها بهولندا ثأر استعماري، على خلاف حالها في فرنسا وبريطانيا مثلا، فإن الإعلام الهولندي أثار منذ سنوات مسألة الهجرة والمهاجرين، وتعلُّمهم لغتهم الأم. وقد أَولاها الباحثون والأكاديميون الهولنديون أهمية بارزة، وهم يكثرون من الدراسات التي تتناولها.
توجّس هولندي من العربية
ففي عام 2016 مثلا، نشرت صحيفة “فولكس كرانت” الهولندية الواسعة الانتشار، تقريرا عن تجمعات أسر سورية مهاجرة حديثا في هولندا، وشرعت مبادرة ذاتية أو خاصة في تنظيم دورات لتعليم أطفالها اللغة العربية في عطلة نهاية الأسبوع. وقد سمحت بلديات وإدارات مدارس رسمية آنذاك باستخدام قاعات تدريس فيها لتلك الدورات التي تضمنت أيضا تدريس بعض تعاليم الدين الإسلامي العامة. وحسب الصحيفة عينها، كان يدير تلك المبادرة متطوعون مهاجرون سوريون في الغالب، ويدرس في كل فصل من فصولها ما بين 20 إلى 100 طفل. وانطوى التقرير على شيء من الريبة والتوجس تحت عناوين، منها: “دروس لغة عربية في عطلة نهاية الأسبوع، هل تعوِّق اندماج الأطفال السوريين؟”.
يشكل السوريون، بين اللاجئين والمهاجرين العرب، الجالية الثانية عددا، والأحدث زمنا في هولندا، بعد الجالية المغربية الأكبر والقديمة نسبيا. هذا فيما يحتل العراقيون المرتبة الثالثة من حيث عددهم، يليهم المصريون. وحديثا تزايد عدد المهاجرين واللاجئين من اليمن والسودان.
في هولندا، في مدنها على وجه التحديد، يخالط المهاجرون من أصول عربية، من هم أقدم منهم وفادة وهجرة، كالسورناميين في أميركا الجنوبية، والإندونسيين في شرق آسيا، والصينيين والأفارقة السود. حتى أن كثافة الخليط “الملون” في مشاهد الحياة اليومية في العاصمة أمستردام، تكاد تطغى على حضور الهولنديين “البيض”، أو تجعلهم جزءا من ذاك الخليط البشري الواسع. وهناك من يقول إن علّة ذلك هي إن هولندا من أقدم البلاد الاستعمارية في الأزمنة الحديثة، وليست بلدا قوميا، أو ضعيف القومية في تكونه.
لكن مسألة أو معضلة الهجرة والمهاجرين في هولندا تجاوزت راهنا مسألة تعليم اللغة العربية بأشواط. ففي خريف العام الماضي (2023) فاز اليمين المتطرف في الانتخابات الهولندية العامة. وهناك إجماع على أن أسباب ذاك الفوز المفاجئ، خوف الهولنديين “البيض” من الهجرة والمهاجرين واللاجئين، بل من إسلامهم تحديدا، وخصوصا بعد موجة اللجوء السوري الأخيرة الكبيرة إلى أوروبا. وهذا عارض أوروبي كبير وواسع ومؤثر سياسيا بقوة، وصار مشهورا باسم الإسلاموفوبيا.
حيرة وازدواج وقطيعة
وكانت الصحيفة الهولندية المذكورة قد تساءلت عن أسباب إصرار ذوي الأطفال العرب المسلمين على تعليم أبنائهم اللغة العربية. والحقيقة يبدو السؤال نفسه – حسب تعليق بعض المهتمين – غير منطقي إلى حد ما. فهو ينطوي على افتراض ألا يقدم المهاجرون على تعليم أبنائهم لغتهم الأم، العربية أو سواها من اللغات حسب بلاد المهاجرين. والافتراض هذا هو ما يحتاج إلى تفسير وتبرير، وليس العكس.
والأرجح أن الافتراض إياه وصيغة السؤال الواردين في وسيلة إعلامية هولندية، هما ما دفع كثرة من المهاجرين العرب الذين استجوبتهم “المجلة” في سياق هذا التحقيق، إلى إجابات براغماتية وتبريرية، تتقاطع في ما يمكن تلخيصه على النحو الآتي: نحن لا نزال نحمل بطاقات إقامة موقتة. ومسألة بقائنا في هولندا لا تزال في نطاق الموقت أيضا. لذلك لا تزال العربية، بشكل أو بآخر، مهمة لنا ولأولادنا. فالوجهة النهائية لإقامتنا وحياتنا غير معلومة بعد.
وعزا بعض المستجوبين إطلاقهم مبادرات خاصة لتعليم أطفالهم العربية، إلى إقدام الحكومة الهولندية على إلغاء تعليم اللغة العربية في المدارس التي كانت تدرسها سابقا مثل باقي اللغات الأخرى التي يحق للطالب اختيارها إلى جانب اللغتين الأساسيتين: الهولندية والإنكليزية.
التقرير الصحافي الذي أبدى توجّسه من مبادرة عائلات مهاجرين إلى تنظيم دورات خاصة لتعليم أولادهم لغتهم الأم إلى جانب الدين الإسلامي، ذُيّل بآراء خبراء أشار بعضهم إلى أن هذه الدروس في عطلة نهاية الأسبوع، لا تقف عائقا أمام اندماج الأطفال في المجتمع الهولندي. واعتبر آخرون أن قطيعة أبناء المهاجرين الثقافية مع لغة ومواطن أهلهم الأصلية، يمكن أن تتسبب بمشاكل نفسية عميقة على المدى البعيد. وهناك من الباحثين من يفسر بعض عناصر ظاهرة الإرهاب الإسلاموي بتلك القطيعة التي يصحو منها أفراد من جيل المهاجرين المسلمين الثاني أو الثالث.
القطيعة هذه تؤرق فعلا الجيل الأول من المهاجرين العرب والملتحقين في السنوات الأخيرة بقطار الهجرة واللجوء جرّاء الحروب والصراعات في كثرة من بلدان المنطقة العربية. فاللغة العربية، عدا كونها لغة تواصل وثقافة، هي لغة صلاة وشعائر المسلمين الدينية، وهم يشكلون غالبية المهاجرين في هولندا. وهي أيضا مدخل إلى عالم ثقافي، اجتماعي وتاريخي متكامل، قلّما حازت لغة حية مثله.
بالتالي، فإن ما يعيشه العرب المسلمون في هولندا من حيرة وتأرجح وازدواج في رغبتهم تعليم أبنائهم لغتهم الأم، ينطوي على قدر من المشروعية الثقافية، الدينية والاجتماعية.
لكن رغبتهم ومبادراتهم الخاصة لتحقيقها لا تلقيان دعما كافيا لاستمرارها. والباحث عن مدارس لتعليم الأطفال اللغة العربية لاستطلاع أوضاعها، يجد صعوبة كبيرة للعثور عليها، بسبب ندرتها. في المقابل، سرعان ما تظهر المساجد ومراكز الجمعيات الإسلامية كبديل متاح وشبه مجاني لتعليم اللغة العربية. لكن المستطلع يكتشف أنها تقدم دروس اللغة في إطار ديني دعوي يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ نوع من أنواع العقيدة الإسلامية. وهذا ما يرحب به معظم أولياء أمور الأطفال المهاجرين المغاربة والسوريين وسواهم من العرب المسلمين. وإذا تردد بعضهم في إلحاق أبنائهم بالدروس التي تقدمها المساجد والجمعات، فإنهم غالبا ما لا يجدون خيارا آخر، فيضطرون إلى أن يتلقى أولادهم دروس العربية ضمن دروس دينية، ويظل يساورهم حذر مما يتعلمه أولادهم، لاعتبارات تتصل بالرؤى والتصورات المختلفة حول فهم الإسلام وممارسته.
العربية والانقسام الهولندي
مسألة دمج تعلم العربية بتلقي دروس دينية في المساجد ولدى جمعيات رابطها ديني، لا يقتصر الجدال حولها على حيرة المهاجرين وبحثهم عن خيارات أخرى. ذلك أن الهولنديين ينشغلون بالمسألة عينها كذلك، وعلى نحو منقسم ومتباين. فحين بادرت جامعة أمستردام إلى إجراء دراسة استطلاعية مؤخرا، جعلت عنوانها: “ماذا يُعلَّم الأطفال في المساجد؟”. وكما يقال إن “المكتوب يُقرأ من عنوانه”، انطلقت الدراسة من توجّس حيال المساجد والدروس التي تقدمها إلى الأطفال الهولنديين من أبناء المهاجرين.
أما الدراسة التي أجرتها جامعة أوترخت الهولندية، فجاء عنوانها مختلفا: “خرائط لخطابات التعليم في المساجد بهولندا وتحليل محتوى الخطاب الإعلامي الهولندي حولها”. وانطوى التحليل على ما يشبه الرد على صيغة التوجس التي تلابس باستمرار مشاعر فئات هولندية واسعة حيال الهجرة والمهاجرين، وخصوصا سلوك العرب المسلمين وانشغالهم بشؤون لغتهم ودينهم. وخلصت هذه الدراسة إلى أن الإعلام يسعى عموما إلى تصوير ذلك الانشغال تصويرا سلبيا، وربطه بتعزيز القيم المحافظة أو المتشددة في الكثير من الأحيان.
وعلى نحو ما يتخذ طابعا دينيا تعليم العربية لأبناء المهاجرين في المساجد وفي رعاية شبكات جمعياتهم، ويثير لغطا في دوائر من المجتمع الهولندي، غالبا ما يوصف بالتسييس تعليم العربية وثقافتها في بعض الجامعات الهولندية. فأحد الباحثين من العاملين في جامعة أمستردام – وهو من أصول عربية، ولم يشأ الأفصاح عن اسمه – ذكر أن تعليم العربية وكل ما يتصل بالدراسات الشرقية، وتحديدا الشرق المسلم، صار يُنظر إليه في العقدين الأخيرين باعتباره ينطوي على طابع سياسي. المحاضرون في أقسام الدراسات الثقافية العربية ودراسات الشرق الأوسط والأسلاميات، تراجع إتقانهم اللغة العربية. وصار قلما يحتاج إلى إتقان العربية دارسو الاجتماع السياسي والإنسانيات في منطقة الشرق الأوسط. وهذا انعكس على متخرجي هذه الأقسام ونوعية معرفتهم وأبحاثهم حول المنطقة.
في خضم هذه التجاذبات تظل خافتة وغير معروفة حكايات ورؤى وشهادات الناس الذين يريدون أن يتعلم أبناؤهم العربية ويجيدوها، سوى معرفة جزئية أو ضبابية. لذا يحاول هذا التحقيق استطلاع الدوافع الفعلية والأبعاد الانسانية والثقافية الكامنة في إرادتهم تلك، بصرف النظر عما تثيره من توجس في دوائر من المجتمع الهولندي ولدى السلطات والإعلام المتحفّز في هولندا. وكذلك عما قد تسعى إليه مؤسسة دينية أو سياسية.
الإسلام هدف تعليم العربية
رحبت صديقتنا (وهي مغربية محجبة ومتدينة تدينا تقليديا، وتقيم في هولندا منذ ثلاثين سنة) باصطحابنا إلى مركز إسلامي تدرس فيه ابنتاها اللغة العربية والعقيدة الإسلامية. تدير المركز جمعية إسلامية في حي من أمستردام يكثر فيه المغاربة. التباين بين مقاربتها ومقاربتنا للدين والتدين، لم يمنع صداقتنا، ولا دعمها لإحدانا في بعض مقتضيات حياتها الجديدة في أمستردام. وأخبرتنا الصديقة أن المركز – المؤسسة التي تُعنى بالتدريس هي مسجد أيضا. ولما وضعت كل منا شالا أو غطاء للشعر على رأسها، ابتسمت الصديقة وهزّت رأسها مستحسنة.
أثناء تجاذبنا الحديث في سيارتها، أوضحت – وهي تضغط على مخارج الحروف في كلامها – أن حرصها، وصديقاتها من أمثالها “الملتزمات” دينيا، على تعليم أولادهن اللغة العربية، نابع في الدرجة الأولى من حرصهن كأسر مسلمة مهاجرة، على أن يتعلم الأولاد شؤون عقيدتهم. كأنها تقول إن الهجرة هي عامل إضافي ومحفز على ذاك الحرص المزدوج (اللغة العربية والدين الإسلامي) الذي لا تنفصم عراه.
وهي أضافت: “يهمنا أن يتعلم أولادنا الإسلام، حتى بلغة غير العربية. فإلى جانب تعليمهم في المدارس الهولندية الرسمية التي لا تهتم بالدين والتدين، نلحقهم بدروس هذه المؤسسة الإسلامية. ما يهمها أن يتعلموا العقيدة ولو باللغة الهولندية”.
دِين أجيال جديدة
إحدى الأمهات المغربيات من اللواتي قابلناهن في المؤسسة – المسجد، قالت بنبرة تستبطن نقدا أو تصحيحا لوضع مختل من وجهة نظرها: “الجيل الأول من آبائنا وأمهاتنا المهاجرين كان معظمهم غير متعلمين. وقد حرصوا على تعليمنا عادات وتقاليد بلدهم الأم أكثر من حرصهم على تعليمنا فرائض الدين. نحن اليوم نفعل العكس”.
خارج مبنى المؤسسة الإسلامية تجمهرت عشرات من الأمهات – جميعهن محجبات – وقلة من الآباء، في انتظار خروج أبنائهم. بدا المبنى عاديا، ويشبه المباني السكنية ولا شيء فيه يشير إلى أنه مسجد. وفسر الذين قابلناهم: “هذا النوع من المساجد هو في الأصل مبان سكنية، تبرع بها أفراد من الجاليات المسلمة في هولندا”.
في داخل المبنى – المسجد ازدحمت غرفتان مخصصتان للتدريس بطفلات معظمهن بين العاشرة والرابعة من العمر. يرتدين أثوابا فضفاضة طويلة، تغطي شعورهن وتنسدل حتى أقدامهن. وهي تعرف بـ “شرشف/مشمر الصلاة” المعتبر زيا رسميا داخل المدرسة. انكبت بعض الفتيات الصغيرات على ترتيب غرف الدرس. إحداهن تحرك مكنسة كهربائية لتنظيف غرفة جانبية قيل لنا إنها مصلى.
إمام العقيدة
للرد على أسئلتنا واستفساراتنا، بادرت سكرتيرة المركز – وهي محجبة، وقالت إنها لا تتحدث العربية بل الدارجة المغربية – إلى استدعاء مدير المؤسسة، وهو إمام المسجد. عرّف عن نفسه بأنه متخصص في الدراسات الإسلامية ومتخرج في جامعة لايدن الشهيرة.
أثناء إنجازنا هذا التحقيق، نشرت صحف ومواقع إخبارية هولندية رسالة من وزيرة الشؤون الاجتماعية فان خينيب إلى مجلس النواب، أبدت فيها أسفها على طريقة إجراء وزارتها تحقيقات عن المسلمين والمساجد في هولندا. وقد تبيّن أن بعض البلديات استأجرت وكالة أبحاث خاصة للتحقيق حول المنظمات الدينية الإسلامية، فركزت استطلاعاتها على أتباع المذهب السلفي. وحسب رسالة الوزيرة، استُخدِمت في التحقيق أساليب ملتوية تفتقر إلى الشفافية. وقد جُمعت بيانات شخصية عن المسلمين والمؤسسات الإسلامية والمساجد على نحو لا يسمح به القانون الهولندي. ووعدت الوزيرة بتدميرها ومسحها من أرشيف قاعدة بيانات الوزارة.
شرحنا لمدير المؤسسة – المسجد وإمامه أن أسئلتنا عامة، فوافق على الإدلاء بمعلومات مقتضبة، أفادت أن المدرسة تعلم العقيدة الإسلامية واللغة العربية، وتضم 1100 طالب وطالبة، موزعين على 13 فصلا للذكور و14 للإناث. وهناك 670 طلبا على قائمة انتظار الالتحاق بالمدرسة. وشرح المدير أن لدى المؤسسة منهجا لا يركز على تدريس العقيدة بالعربية بل بالهولندية. أما اللغة العربية فليست أساسية في برنامج التدريس. وهي تُعتمد في العبادات ولمهارات القراءة، بهدف اتقان الأطفال قراءة القرآن. وتستخدم في ذلك “القاعدة النورانية”.
وقال المدير إن التعليم يهدف في الدرجة الأولى إلى ربط الأطفال بهويتهم الإسلامية التي تتقدم على الهوية العربية. ويضم منهج المؤسسة دروسا في السيرة والفقه والتوحيد، وجلسات تربوية تُستخدم فيها كتب مبسطة، “كهذا الكتاب” الذي رفعه المدير بيده، فإذا به باللغة الهولندية، وترجمة عنوانه: “موعد مع الملك”. وهو أوضح: “يقصد بالملك الله سبحانه وتعالى”. وختم كلامه قائلا إن المؤسسة أطلقت منصة إلكترونية مجانية عبر الإنترنت، لمن يطلب التعلّم. ويتضمن المنهج دورات للأبوين أو أحدهما على الأقل.
مصاعب عربيةِ الدنيا
لدى خروجنا من المدرسة رأينا أن الأهل لا يزالون مجتمعين خارجا في دوائر محادثة تشير إلى أن تعارفا أليفا يسري بينهم. ولما لمحنا امرأة واحدة سافرة بين النساء المحجبات – سمى أمثالهن في لبنان الباحث والأكاديمي الراحل حسن قبيسي “أخوات الظل واليقين” – قررننا التوجه إليها، لكنها سرعان ما ركبت سيارتها وغادرت. وقالت صديقتنا المغربية المحجبة إن وجود غير المحجبات بين أمهات المتعلمين/ات أمر عادي، فسألناها: ألا يخلق إلزام الأولاد نظام المؤسسة التربوي قطيعة وتشوشا في علاقة تلامذتها بأهلهم غير الملتزمين دينيا؟ فأجابت الصديقة مبتسمة: ألسنا في بلد يحفظ الحريات الشخصية؟ فران صمت بيننا.
بعض من قابلناهم في المدرسة وسواها من أمثالها، ذكروا وذكرن أسبابا ثقافية، شخصية وعاطفية واجتماعية لحرصهم على تعليم أولادهم العربية. وأبدوا تخوفهم من أن يتحول تعليمها إلى غايات أخرى. وحدسنا أن المرأة السافرة من هؤلاء الذين واللواتي يرون ويرين أن العربية، كسواها من اللغات، أداة تواصل دنيوي متحول ومتغير، على الرغم من خصوصية كل لغة وحميميتها بالنسبة إلى أهلها. أصحاب هذا الرأي يشددون على المساحة المشتركة التي تقيمها العربية بينهم وبين أولادهم الذين يتحدثون لغة موطنهم الجديد. والمساحة تلك هي الجسر الذي يربط الأبناء بأهلهم وبمواطن أهلهم.
لكن مهمة هؤلاء أصعب بكثير من مهمة من يوكلون إلى مدارس المؤسسات الدينية تعليم أولادهم العربية وتعاليم الإسلام. ذلك لأن المدارس الرسمية الهولندية “العلمانية” حذفت من برامجها العربية كخيار لغوي. هذا فيما مدارس الجمعيات والمساجد تقدم اللغة وفق وجبة عقائدية كاملة متكاملة، يحذرها المضطرون إلى تعليم أبنائهم فيها.
إحدى الأمهات
المنحى الفردي الحذر جسدته أم عربية شابة متزوجة من هولندي، وعرّفت عن نفسها بأنها تعمل في مجال الإنتاج المسرحي والثقافي في هولندا. وهي قالت: “أحرص بشدة على تعليم أطفالي اللغة العربية. فلغتهم الأم جزء من هويتهم وتراثهم الثقافي، وتوثِّق صلتي بهم وتمنحها تاريخا متصلا لا تشوبه قطيعة. وبالعربية أستطيع التعبير والتواصل على نحو أفضل، ويصعب أن تصبح الهولندية لغتي الأم مهما اتقنتها. خوفي من محدودية التواصل والحديث والمناقشة مع أطفالي بالهولندية يجعلني أشد إصرارا على أن يتعلموها. ثم إنني أرغب في تمكينهم من التواصل مع الأسرة والأصدقاء في بلدي الأول”.
وبحسرة أردفت: “لم أرسل أولادي إلى أي مدرسة بعد، لأنني لم أجد المدرسة المناسبة التي تعلم اللغة العربية من غير ربطها بأيديولوجيات معينة أو بتعليم ديني. فالدين عندي شخصي جدا. وعلى الرغم من أنني مسلمة أفضل لأطفالي أن يختاروا دينهم بأنفسهم. وأفضل نقل المعتقدات والقيم لهم بطريقتي ووفق رؤيتي”. وقالت إنها تعرف أسرا عربية مسيحية أو لادينية تود لأولادها أن يجيدوا اللغة العربية ومعرفة ثقافتها، ثقافة بلدهم الأول، ويتجنبوا الصبغة الدينية الإسلامية. وأضافت: “هذا الربط بين الدين والعربية لحقنا إلى هنا في الغرب، حيث يطغى الدين في بعض دوائر المهاجرين على الهوية واللغة والثقافة”.
العربية رسما وغناء
لرصد تجليات هذه الحالة المركبة بين اللغة والهوية والثقافة لدى الجيل الثاني من المهاجرين – وهو إما ولد في الغرب أو هاجر مع أهله في سن مبكرة – التقينا أسرة عربية مكونة من والدين وابن وابنة. الطفلان هاجرا مع والديهما في سن مبكرة، مما جعل اللغة العربية لكليهما لغة مسموعة فقط، على خلاف الإنكليزية والهولندية اللتين تعلماهما كتابة وتحدثا.
في أثناء حديثنا مع الوالدين وتدوين ملاحظاتنا، اقتربت منا الصغيرة مشيرة إلى ورقة الملاحظات المدوّنة بالعربية متسائلة: “ماما شو هيدا؟”. جاوبتها أمها: “هذا عربي ماما”. وهتفت الطفلة: “أنا أعرف كتابة بابا بالعربي!”. ولما كتبت “بابا” على دفتر ملاحظاتنا، لاحظنا أنها ترسمها رسما، ومن اليسار إلى اليمين، وبدأت برسمها بألف المدّ ثم الباء، فألف المد ثم الباء مجددا.
تمثل كتابة العربية في ذهن الطفلة خطوطا، ووفق المنظومة الأساسية التي تلقتها في التعليم الأساسي في المدارس الهولندية. لذا فإن زرع منظومة أخرى موازية في ذهنها يصبح مهمة شاقة، يحاول والدها في الغرب تحقيقها. وحين سألنا الوالد عن سبب رغبته في تعليم ابنيه العربية، جاء جوابه بسيطا: أريد لطفليّ أن يفهما نكاتي، لنضحك معا. وأريدهما أن يغنيا معي عندما أعزف على الغيتار. لئلا تصير اللغة جدارا يعزلنا”.
——————————-
العربية في فرنسا بين تطرّفين :الإسلاموية والإسلاموفوبيا/ صبر درويش
عدد تلامذة اللغة العربية في 1986 لم يتجاوز 13 ألفا وفي 2000 تقلص إلى 7 آلاف
آخر تحديث 25 مارس 2024
لم تُثِر لغة أجنبية سجالا في الأوساط السياسية والعلمية والتربوية في فرنسا بقدر ما أثارته اللغة العربية وأثاره تعليمها لـ “المسلمين الفرنسيين العرب”. فمسألة تعلم اللغة العربية وحق ما يسمى “الإسلام الفرنسي”، أو “المسلمين الفرنسيين” على وجه الخصوص، بتعلمها، غالبا ما نُقِلت من حقل المعرفة والتعلم والثقافة إلى حقل الدين والسياسة والأيديولوجيا. فجرى خلط مستمر بين اللغة العربية من جهة، والدين الإسلامي ولغته، “لغة القرآن”، من جهة أخرى، حتى كادت تختفي الحدود بين الوجهين. وربما أُهمل عن قصد السياق التاريخي الذي يؤكد أن اللغة العربية أقدم من الإسلام، الذي لا يعدو كونه جزءا من تاريخ اللغة العربية.
دراما استعمارية وأمنية؟
يترتب على هذا الخلط الذي غالبا ما تتبناه أوساط التيار الشعبوي واليمين المتطرف الفرنسيين، خوف فرنسي من تغلغل الإسلام السياسي وما يرافقه من تطرف في أوساط الفرنسيين الناطقين بالعربية. أما الأوساط السياسية الفرنسية الأقل شعبوية وتطرفا يمينيا، فتخلط بين اللغة والثقافة العربيتين وبين الهوية العربية والإسلامية، لتحذِّر من نزعة “الإسلام الفرنسي” إلى انفصال محتمل عن الدولة الفرنسية وعن هوية الجمهورية الفرنسية. وهذا ما يقف عائقا من جملة عوائق أخرى في وجه تكيف “المسلمين الفرنسيين” (اندماجهم؟) الاجتماعي، ويدفع بالراغبين في تعلم اللغة العربية إلى مزيد من التقوقع والعزلة والانغلاق.
ولخص مدير قسم تعليم اللغة العربية في معهد العالم العربي بباريس، محمد قرقور، الحال هذه فقال لـ”المجلة” إن “تعليم لغة الضاد في فرنسا يعاني من مشاكل عدة، بينها نقص في الإرادة السياسية الفرنسية التي تتقاعس عن إتاحة تعلم اللغة العربية لكل الراغبين من الفرنسيين والمقيمين في فرنسا، بلا عوائق وبلا مخاوف أيديولوجية. ومنها أيضا انتشار الصور النمطية الخاطئة عن الإسلام واللغة العربية لدى بعض الفرنسيين الذين يطابقون بين تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي، وأحيانا بينهما وبين التطرف والإرهاب. وهذا غير صحيح مطلقا”، حسب قرقور.
لكن في نواة أو عمق مسألة تعلم العربية وما يسمى “المسلمون الفرنسيون”، يكمن تاريخ العلاقة الاستعمارية المأسوية المعقدة بين فرنسا والجزائر التي تنحدر منها كبرى جاليات “الإسلام الفرنسي”. ففرنسا في الحقبة الاستعمارية كانت تعد الجزائر أرضا فرنسية، وأقدمت على تكريس رغبتها في فرنسة الجزائر. وقد نجم عن ذلك تدمير المجتمع الجزائري المحلي وهويته ولغته في تلك الحقبة التي لا تزال الجزائر تعاني من آثارها حتى اليوم.
هناك تاليا استقدام فرنسا من بلاد المغرب العربي، وتحديدا الجزائر، ما تحتاج إليه من عمالة رخيصة للأعمال القاسية والمضنية. شكل أولئك العمال وعائلاتهم منذ الحرب العالمية الثانية جالية مهمشة ومقصية في فرنسا، ينطوي وجودها على “دراما استعمارية” متناسلة شديدة التعقيد. من وجوهها أن “الإسلام الفرنسي” يعدّ اللغة العربية والدين الإسلامي من عناصر هويته التي يخاف منها جمهور فرنسي واسع على هويته الفرنسية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد “المسلمين الفرنسيين” يتجاوز الستة ملايين نسمة.
منذ مطلع الألفية الثالثة استجد في أوروبا كلها الخوف من التطرف الإسلاموي وما يرافقه من عنف. وقد أُضيف هذا إلى قلق فرنسي مما يسمى “النزعة الانفصالية” لدى “مسلمي فرنسا”، ومما تنطوي عليه من تهديد لبنى المجتمع الفرنسي ووحدته وتماسكه الاجتماعي والوطني.
وهاتان الحجتان (الإرهاب الإسلاموي، والنزعة الإنفصالية) هما الأساسيتان اللتان جعلتا من تعلم اللغة العربية والحق في تعلمها أمرا شديد التعقيد في فرنسا. وهذا ما أخّر إلى حد بعيد إدراج اللغة العربية في مناهج التعليم الوطنية أسوة بسواها من اللغات الأجنبية المدرجة في نظام التعليم، كالروسية والصينية والألمانية، علما أن أعدادا كبيرة من سكان فرنسا يتحدثون اللغة العربية التي تتصدر المرتبة الأولى بين اللغات الأجنبية في فرنسا، وتأتي بعدها اللغة الصينية، بسبب كثرة أعداد الجالية الصينية المقيمة في فرنسا.
هذا كله أدى إلى أن تكون المقاربة الفرنسية لتعلم اللغة العربية “مقاربة أمنية” حسب ميما شهال، وهي طالبة دكتوراه علوم سياسية في مدينة مرسيليا الفرنسية. والمقاربة الأمنية غالبا ما تقود إلى ربط تعلم اللغة العربية بمسائل الإرهاب والإسلام السياسي.
متاهة أسباب سلبية
على الرغم من كل الاعتراضات التي واجهت إدراج اللغة العربية في مناهج التعليم الرسمية الفرنسية، أصبحت العربية “رسميا”، بحلول عام 2017، خيارا متاحا لمن يشاء تعلمها في المدارس. لكن تنفيذ ذلك على أرض الواقع لا يزال بعيد المنال إلى حد كبير.
لماذا؟ أولى المشكلات التي تبرز أمام تعلم العربية تكمن – حسب شهال – في النقص الشديد في كوادر تعليمها في فرنسا. يوازيه نقص في خبرات المعلمين. فقد بلغ عدد مدرسي اللغة العربية في عموم فرنسا نحو 200 مدرس، موزعين على المدارس الفرنسية كافة. وهذا رقم قليل. وهو ناجم عن طبيعة الإهمال التاريخي لتعليم اللغة العربية في المدارس والجامعات الفرنسية. وهي المؤسسات المخصصة لإنشاء الكوادر القادرة على تعليمها.
إضافة إلى الإهمال، هناك القطيعة بين التعليم الثانوي والجامعي في مجال تعليم اللغة العربية في فرنسا. وهذا أمر “مدهش” على حد تعبير الباحث المتخصص باللغة العربية، ميلود غرافي. والباعث على هذه القطيعة ثقافي ونخبوي. فالمستعربون الفرنسيون والباحثون ومدرسو الإسلاميات والحضارة والثقافة العربيتين والإسلاميتين في الجامعات، لا صلة لهم بالتعليم ما قبل الجامعي. وغالبية طلاب الدراسات الجامعية العليا من أصول عربية، غالبا ما كانوا يعودون للعمل في بلدانهم بعد حصولهم على الشهادات من جامعات فرنسا. أما أبناء المهاجرين من بلدان مغاربية فلا يقبِلون إلا في ما ندر على دراسات عريبة وإسلامية في فرنسا.
ويقول السيد أبو سلمى – هكذا رغب التعريف بنفسه، وهو مدرس لغة عربية أكاديمي قدم من سوريا إلى فرنسا في العام 2015 – لـ “المجلة”: “بعد وصولي إلى فرنسا واستقراري فيها، تواصلت مع رئاسة قسم اللغة العربية في جامعة جان جوريس في مدينة تولوز جنوب البلاد للانضمام إلى كادر التعليم، خصوصا أن لدي الخبرة والمؤهلات الكافية لذلك. إلا أن المعوقات التي وُضعت أمامي كانت من الصعوبة التي حملتني، بعد مضي بعض الوقت، على التخلي عن الفكرة. فإدارة المدارس والتعليم عموما شديدة المركزية والبيروقراطية في فرنسا، وهي غالبا ما تستريب من إرادة المهاجرين العرب والمسلمين واقبالهم على الانخراط في تعليم لغتهم في المدارس الرسمية”.
لا تقتصر المشكلة على عدم توفر الكادر المطلوب. فالمدارس في المناطق التي تتحكم بإدارتها المحلية هيئات يمينية، على سبيل المثل، قد تقرر إدارتها استبعاد تدريس اللغة العربية من الخيارات المتاحة للتلاميذ. وحتى في حال عدم استبعاد إدارة المدرسة اللغة العربية لأسباب أيديولوجية ودينية، فإن عدد طلاب اللغة العربية الضئيل يلعب دورا في استبعادها. وتقول شهال: “حتى لو وجد مدرس للغة العربية، وحتى لو كانت إدارة المدرسة ترغب في إدراج اللغة العربية في صفوفها، فإن المشكلة التي قد تواجه الإدارة تتعلق بقلة عدد التلاميذ الذين يختارون دراسة اللغة العربية. والقلة هذه تحمل إدارة المدرسة على عدم فتح صف لهم”.
طالبة في مدرسة تولوز الثانوية (16 سنة، تنحدر من أسرة مغاربية) قالت لـ “المجلة”: “لم أكن أعلم أن اختيار دراسة اللغة العربية متاح في المدرسة. لذا اخترت اللغة الإسبانية عندما كنت في المرحلة المتوسطة. وفي مرحلة التعليم الثانوي علمت أنني أستطيع دراسة العربية عوضا من الاسبانية. وعندما باشرت التسجيل علمت أن عليّ أن أحضر صف اللغة العربية في مدرسة أخرى، تبعد كثيرا عن الحي الذي أقطنه. زيادة على ذلك وجب على والديّ دفع مبلغ من المال ليس بالقليل، من أجل حضوري في الصف. لذا تخليت عن الفكرة وتابعت تعلم الإسبانية”.
أرقام وخيارات وجهات
تشير الأرقام الإحصائية إلى أن عدد تلامذة اللغة العربية في العام 1986 في فرنسا، لم يكن يتجاوز 13 ألف تلميذ. وفي العام 2000 تقلص العدد ليصل إلى 7 آلاف تلميذ فقط في عموم فرنسا. وارتفع العدد تدريجيا ليصل إلى نحو 14 ألف تلميذ في العام 2019. وذلك من إجمالي نحو 5.5 مليون تلميذ فرنسي. وهذا ما يشكل زيادة نسبية، مقارنة بعدد تلاميذ اللغة العربية في العام 2007، الذي وصل إلى نحو 6500 تلميذ، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
على الرغم من أن تعلم اللغة العربية في المدارس الرسمية الفرنسية هو الخيار الأفضل للتلامذة على المستويات كافة، لكن المعوقات التي أوردناها أعلاه، أدت إلى بروز المدارس والمعاهد الخاصة كملاذ أكثر استقطابا لتعليم اللغة العربية.
تأتي المساجد في فرنسا وسفارات الدول العربية فيها في مقدمة الجهات التي تقدم دروسا في اللغة العربية. وحسب تقرير صادر عن “المعهد الفرنسي للاندماج”، درس في العام 2015 نحو 75 ألف تلميذ اللغة العربية في الصفوف الخاصة التي تنظمها السفارات. لكن هؤلاء يظلون خارج الجسم التعليمي الفرنسي، أي خارج إشراف وزارة التربية.
معهد العالم العربي
يعد معهد العالم العربي أحد أهم مراكز تعليم اللغة العربية خارج إطار التبعية السياسية والأيديولوجية، وهو يركز بشكل خاص على تعليم العربية وما يرافقها من نشاطات ثقافية وفنية الطابع.
ويعد معهد العالم العربي في باريس، بإدارة جاك لانغ وزير الثقافة السابق، من أهم الجهات الفرنسية في تعليم اللغة العربية. وقد يكون الجهة الوحيدة المخولة منح شهادة في اللغة العربية معترفٍ بها فرنسيا ودوليا. وهي شهادة “سمة”، معترف بها رسميا منذ العام 2019. ويتخرج سنويا من المعهد عشرات الطلاب الحائزين شهادة رسمية في تعلم اللغة العربية، وتعترف بها وزارة التربية الفرنسية.
وكان المعهد قد خصص قسما خاصا لتعليم اللغة العربية، وهو “مركز اللغة والحضارة العربية” الذي يهدف إلى النهوض باللغة العربية لغة للتواصل، وإلى المساهمة من خلال اللغة في فهم أفضل للعالم العربي المعاصر. وهذا إضافة إلى تنظيم دورات لغة عربية لفئات الجمهور المختلفة. وحسب مدير المعهد عبد الغني سباطة، أقيم المركز من أجل تطوير وتعميق تعليم العربية وفهم العالم العربي وثقافاته المتعددة.
مساجد للغة والدين
ربما تتحمل الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية مسؤولية كبيرة في ربط اللغة العربية بالدين الإسلامي. لكن المساجد لها نصيبها الوافر من هذه المسؤولية.
وقد يكون الإقبال الكثيف على تعلم العربية في المساجد، يتعلق بالهوية ولغتها الأم، وكي يستخدمها متعلموها من أبناء جاليات الإسلام العربي الفرنسي للتواصل في دائرة الأسرة وضمن العلاقات الاجتماعية المحيطة بها. لكن ربط أو ارتباط فهم الدين الإسلامي وشعائره بضرورة تعلم اللغة العربية، يجعل من العربية نفسها عاملا “استقطابيا” على حد تعبير شهال. فتصبح المسألة معكوسة، أي تعلم اللغة العربية من أجل فهم الدين ومحاولة الاجتهاد الفقهي.
أحد اللاجئين السوريين في فرنسا (كان مدرسا للغة العربية في سوريا، وفضل عدم ذكر اسمه) يقول: “بعد مضي نحو عامين على وصولي إلى فرنسا واستقراري فيها، سعيت إلى البحث عن عمل كمدرس لغة عربية. قصدت أحد المساجد في المدينة التي أعيش فيها، ولاحظت أن دورات تعلم اللغة العربية تتضمن برنامجا أوسع بكثير من موضوع تعلم اللغة. فإلى جانب حصة تعلم اللغة ثمة ساعات أخرى لتعليم الفقه الديني وتلاوة القرآن. وبما أنني لم أتقن بعد اللغة الفرنسية، فقد اقتَرحت عليّ إدارة الجمعية التي تدير المسجد أن أحضر صفوف تلاوة القرآن. فلربما أستطيع أن أعلم الأولاد نطق اللغة العربية السليم عبر تعليمهم تلاوة القرآن”.
العربية والحجاب
السيدة بيان (لم تشأ الإفصاح عن كنيتها العائلية) قدمت من دمشق إلى فرنسا مع أسرتها عام 2013. لم يكن لديها الكثير من الخيارات لتعليم ابنتها (13 سنة) اللغة العربية، سوى إلحاقها بصفوف تابعة لجمعية مدنية يشرف عليها أحد مساجد مدينة تولوز جنوب فرنسا. تقول: “التقيت في أحد الأيام إحدى المشرفات في الجمعية. تحدثت معي وسألتني إن كنت أفكر في تحجيب ابنتي. علّلت المشرفة ذلك قائلة: من الجيد أن تعتاد الفتاة منذ الصغر على وضع الحجاب”.
“كان الأمر لافتا وصادما” في آن واحد، قالت السيدة بيان التي خلعت حجابها بعد وقت قصير من وصولها إلى فرنسا، على الرغم من أنها كانت تعيش وسط أسرة مسلمة محافظة، وترتدي الحجاب طوال حياتها في دمشق.
أوقفت السيدة الدمشقية دروس اللغة العربية لابنتها، وقررت تعليمها قواعدها الأولية في المنزل، على أن تستمر في البحث عن خيارات أخرى. خيارات تركز على تعليم اللغة ولا شيء آخر. وهذه حال شائعة في أوساط كثرة من المهاجرين والمتوطنين العرب في فرنسا من الراغبين في تعليم أولادهم العربية، حسب شهادة لبناني مسلم مهاجر في فرنسا. وهو عرف نفسه بأنه علماني. وقال: “لا يريد العرب المسلمون من أمثالي توريط أولادهم في تعلم العربية في المساجد. فالمساجد تستغل رغبتنا في تعلمهم لغتهم الأم، كي تعلمهم الدين الإسلامي على هوى ائمتها، وربما بنسخة مشوهة، قد تغير شخصيتهم، وتعوّق اندماجهم في المجتمع الفرنسي”.
المساجد: غاية ووسيلة
يحتل تعليم العربية في المساجد في فرنسا المرتبة الثانية بعد تعليمها في السفارات. وتستقطب المساجد الراغبين في تعلم العربية لأسباب مختلفة. فهي تكاد تكون منتشرة في معظم المدن الفرنسية. ولديها جمعيات أهلية وشبكات واسعة، لا تعد ولا تحصى. وهذا على خلاف المدارس الخاصة والمستقلة القليلة العدد، بل النادرة في مناطق كثيرة.
فهذه الطالبة ميساء (15 سنة، تنحدر من أم سودانية وأب فرنسي) التي التقتها “المجلة”، تقول: “أنا أتعلم العربية في هذا المسجد. ليس لأنني موافقة على كل ما يقدمه من أفكار، بل على العكس. فأنا لا أرضى عن الكثير من الأفكار التي يطرحها إمام المسجد. لكن ليس لدي من خيار آخر لتعلم العربية”.
لكن كثيرين آخرين، على عكس ميساء، يسعون بأنفسهم، بل يسعى أهلهم إلى دمج تعلمهم اللغة العربية بتعلمهم قواعد الدين الإسلامي. بمعنى أنهم لا يعترضون على دروس الدين والفقه التي تقدمها جمعيات المساجد بالتوازي مع دروس تعلم اللغة العربية. وهناك كثيرون يريدون تعليم أولادهم اللغة العربية، “كي يتشربوا تعاليم نسخة من الأسلام قد تكون غريبة عنه ومتطرفة، على ما تريد جماعات إسلاموية تتوخى تكريه العرب والمسلمين بالمجتمع الفرنسي والثقافة الفرتسية”، حسب رأي مدرس لغة عربية في مدرسة رسمية بباريس.
لكن هذه فردوس (14 سنة، وهي فرنسية لأبوين جزائريين) مستمرة في متابعة صفوف تعلم اللغة مذ كانت في الثانية عشرة. وتقول أمها: “ابنتي فرنسية بالولادة، ولكنها تنحدر من أصول جزائرية. وفوق هذا نحن مسلمون. بالتأكيد تعلمت ابنتي وتتعلم دينها في المنزل ومع العائلة أولا. لكن الدروس التي تتلقاها في المسجد ساهمت في تحسين معرفتها بقواعد اللغة العربية من جهة، وقدرتها على قراءة القرآن وفهم دينها فهما أفضل من جهة ثانية”.
وهذا شاب مغربي (17 سنة) يحضر هو وأخته (13 سنة) دروسا لتعلم اللغة العربية، إجاب عن أسباب اختياره تعلم العربية: “والدي من قرر ذلك. بالتأكيد أنا لا أمانع تعلم لغة عائلتي. لكن أبي كان يسعى إلى أن أحفظ القرآن، أو على الأقل بعض الآيات القرآنية. وفي الحقيقة جهدي منصب على حفظ القرآن. وهذه مهمة ليست بالسهلة. فأنا بالكاد أنطق كلمات اللغة العربية”.
لكن يبدو أن مسألة تعلم العربية وحفظ آيات قرآنية، معقدة وتتجاوز خيارات الآباء. ففي كلامنا مع فردوس، وهي تحدثنا بالعربية الفصحى، قالت: “أنا فرنسية، وأريد أن أكون فرنسية طالما الأمر لا يتعارض مع هويتي العربية والمسلمة. وعندما أكون في المدرسة أشعر أنني فرنسية، وأقول إنني فرنسية عندما يسألني أحدهم عن أصولي. لكن ماذا أفعل إذا كان خطاب الكراهية السائد يسعى إلى إقصائنا وتهميشنا، بصفتنا فرنسيين من أصول عربية ومسلمة؟ كأنهم يقولون: انتم لستم فرنسيين، أو لستم فرنسيين كما يجب”. وفي هذه الحال ما ردكم على ذلك؟ سألنا عددا ممن أجرينا معم مقابلات.
هنا تتباين الإجابات. البعض قال إنه يبدأ يشعر بشيء من الضيق حيال فرنسيته، وتنشأ بينه وبينها مسافة قد تتحول إلى نفور منها. آخرون قالوا إنهم ينكبون باجتهاد ومواظبة على دراسة العربية وحفظ سور من القرآن. وفئة ثالثة قالت إنها تزداد تمسكا بفرنسيتها وبتعلم العربية وأداء فرائض الدين.
لماذا يتعلم المهاجرون العربية؟
هكذا يبدو أن تعلم “المسلمين الفرنسيين” اللغة العربية مسألة غير لغوية في أحوال كثيرة، أو هي تتجاوز اللغة إلى الهوية والمنبت اللذين لا يد للأفراد في اختيارهما. ثم إن اختيار تعلم العربية لا يبدو خيارا فرديا في حالات كثيرة، بل خاضع لأفعال وردود أفعال تتجاوز الشخص الفرد الذي يصير مسرحا لها، ويصعب عليه التحكم بها، وتخترقه تفاعلات اجتماعية تتدخل فيها جملة من عناصر وضعية وظرفية متغيرة ومتحولة.
أشارت جملة المقابلات التي أجريناها مع تلامذة يتعلمون العربية إلى وجود مروحة من الإجابات حول أسباب سعيهم إلى تعلم العربية. ثمة من أجاب بأن تعلم العربية شرط لتعلم الدين الإسلامي، كما في حالة فردوس على سبيل المثل، وآخرون تمثلت دوافعهم في تعلم لغة آبائهم واكتشاف الثقافة التي ينحدرون منها.
طالبة عربية
وائل مثلا (17 سنة، وكان في العاشرة عندما قدم مع عائلته من سوريا) قال: “في البداية لم أكف عن تكلم العربية. فكنت حريصا على الكلام بها في المنزل ومع العائلة. ولكنني مع الوقت بت أنسى كثرة من مفرداتها. وبعض التعابير والاستعارات أصبحت صعبة الفهم بالنسبة لي. والشغف الذي ألمحه في عيني والدي وهو يقرأ لي بعض الأشعار العربية، حملني على الإصرار على دراسة العربية بشكل منهجي”.
يفاخر وائل بحفظه بعض الآيات القرآنية، على الرغم من أنه ينحدر من أسرة مسيحية. ويقول والده إنه ليس قلقا من تأثير تلك الدروس على ابنه. فهو واعٍ إلى أن ما يتعلمه يندرج في إطار الثقافة لا الأيديولوجيا. وازدواجه اللغوي عامل إثراء وتميز له.
معظم طلاب اللغة العربية في فرنسا فرنسيون، لكنهم من أصول عربية، ويصنفون عادة من الأقليات في فرنسا. وعلى الرغم من فظاظة هذا التوصيف، هم فرنسيون في نشأتهم وثقافتهم وحتى في طباعهم. وبعض الباحثين الاجتماعيين يرى أنهم مزدوجون في سلوكهم وتفاعلهم، حسب الدوائر التي ينوجدون فيها. وحسب الباحثة ميما شهال “هم لديهم القدرة على المحاكمة والتفكير والقدرة على التمييز. وفي نهاية المطاف، لديهم القدرة على تمييز ما يودون تعلمه، وإخضاعه للتفكير النقدي واكتشاف ما يمكن إدراجه ضمن الأنساق المعرفية الشخصية”. وهي ختمت كلامها قائلة: “تعلم العربية للفرنسيين من أصول عربية، تعدّ تجربة وعملية اكتشاف، تعديل وتحول وتكيف”.
—————————
هنادا طه: فشلُنا في صناعة المعلّم معضلة العربية المزمنة
محمد أبي سمرا
دراسة شاملة تناولت مناهج تدريسها في بلدان عدة
آخر تحديث 26 مارس 2024
كيف تعيش لغتنا العربية وكيف نعيشها ويعيشها التلامذة والطلاب/ات، وكيف يتعلمونها في مدارسهم اليوم؟ هذا ما وُضع للإجابة عنه وصفيا وتحليليا تقرير واسع عنوانه “مناهج (تدريس) اللغة العربية في العالم العربي – تجارب الحاضر وآفاق المستقبل”. صدر التقرير في ما يزيد على 450 صفحة عن “مركز أبو ظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة” العام 2022. وكان سبقه آخر عن “حال اللغة العربية اليوم”، وصدر أيضا سنة 2021 في عاصمة الإمارات العربية أبوظبي.
فرق بحثية وأكاديمية متخصصة، شارك فيها باحثون من بلدان عربية عدة، وإلى جانبهم آخرون عالميون، وضعوا تقرير “المناهج” الذي قد يكون فريدا في بابه. وهو دراسة وصفية وتحليلية لنماذج من مناهج تعليم اللغة العربية في كل من الإمارات والأردن وتونس والسعودية ومصر.
الدكتورة هنادا طه كانت بين المشرفين على هذه الدراسة البارزة. وهي تشغل كرسي الأستاذية في تعليم اللغة العربية في جامعة زايد بالإمارات. وتولّت سابقا منصب عميدة كلية البحرين لإعداد المعلمين بالإنابة. وعملت لسنوات في جامعة سان دييغو الحكومية في كاليفورنيا أستاذة للغة العربية ومديرة برامج اللغة العربية فيها. هذا إضافة إلى وضعها أبحاثا ودراسات متخصصة ومحكّمة في تعليم اللغة العربية ومناهجها.
الحلقة الخفيّة
يصف التقرير الذي وضعتموه عن مناهج تعليم اللغة العربية في المدارس، ويحلل وسائل مكتوبة: فكرة المناهج أو فلسفتها، كتب التدريس، وأدلة المعلمين. لماذا الكتب وليس الممارسة العملية؟
عندما بدأنا بتنفيذ مشروعنا البحثي لوضع تقرير عن المناهج الرسمية لتدريس اللغة العربية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية في عدد من الدول العربية، كان المقرر هو النظر في وسائل التدريس، أي المناهج المكتوبة والمقررة، لوصفها وتحليلها وتقييمها. وهنا لا بد أن أذكر ما ترى أنه ينقص أو يغيب عن المشروع والتقرير. ألا وهو ما أسميه المنهاج الخفي، غير الظاهر أو غير المعلن، الذي تسميه الممارسة العملية داخل الصفوف المدرسية
أضرب مثلا بصريا على ذلك: حين تدخل إلى الكثير من المدارس، فلن تبصر في أروقتها وعلى جدرانها أية كلمة مكتوبة بالعربية. هذا عمليا عنصر من عناصر المنهاج الخفي الذي ينطوي على نظرة سلبية، أو على حكم قيمة سلبي على اللغة العربية. وهذا يتمثّل في أن يُقال لك مثلا: العربية ليست لغة مهمة أو ثانوية. وقد يكون هذا الحكم حكم القيِّمين على عملية تدريسها.
لكن العنصر الأهم في المنهاج الخفي هو ما يحدث في الصفوف المدرسية بين التلامذة والمعلمين، أثناء عملية التعليم. هذه هي الحلقة الأساسية المفقودة. لكنها في الحقيقة والواقع ليست مفقودة. فهنالك أبحاث ودراسات كثيرة تناولتها وأسهبت فيها. وتقريرنا لم يتناولها لأنها لم تدخل في نطاق عملنا أصلا.
هل يمكن مستقبلا رصد هذه الحلقة الخفية أو المفقودة، مقاربتها ووصفها، طالما أنها أساسية أو مركزية في عملية التعليم؟ أي التعرُّف إلى عملية التعليم في واقعها العملي والإجرائي، ووضع دراسات وصفية وتحليلية عنها؟
بالتأكيد يمكن ذلك، ومن الضروري أن يحدث. وهذا يتطلب مشروعا آخر غير الذي أنجزناه، ويختلف عنه تماما. وقد تكون عملية إعداد المعلمين أو المدرّسين جزءا أو مدخلا لهذا المشروع. والحق أنني يمكن أن أحيلك على مقالات ودراسات علمية كثيرة منجزة حول هذا الموضوع. وهي في معظمها تتضمن تذمُّرا من عمليات إعداد المدرّسين وتدريبهم. ثم أن الإعداد وحده، الذي يجري لمرة واحدة، لا يكفي. فالتدريب الدوري ضروري للمعلمين، لتجديد خبراتهم وتفعيلها.
فالمعلمون غالبا ما يكونون ضحايا أنظمة إعداد تعليمية جامعية قاصرة أو جامدة ومتخلفة، لا تمكّنهم من القيام بالعملية التعليمية الحيوية داخل قاعات التدريس. فالمعلم في الصف ليس لديه منهاج محدد ومكتوب لعلاقته بالتلامذة. بل هناك فقط ما لدى المعلم من خزين ثقافي ولغوي وعلم ومعلومات، وخبرات في نقل هذه المواد بأسلوب حي، وشيق تفاعلي، إلى التلامذة، ويدعوهم إلى التفاعل ويحفِّزهم على التجاوب وحب اللغة التي يتعلمونها والاستمتاع بها. وهذه كلها تعتمد على قابلية المعلم وحبه وتقديره المعنوي لعمله.
بناء على خبرتي أستطيع القول إننا نفتقر إلى دراسات إجرائية عربية في هذا الموضوع، وإلى دراسات مقارنة بين بلدان عربية. وملاحظاتي تقول إن قضايا ومشكلات التعليم مشتركة ومتشابهة من هذه الزاوية، حتى بين الدول العربية الفقيرة والأخرى الغنية.
مشكلة إعداد المعلمين
هل يمكن، بناء على خبرتك وملاحظاتك، الحديث عن هذه المشتركات؟
هذا يحيلني فورا على الكلام على عملية إعداد المعلمين التي تعود برامجها إلى نحو 150 سنة ولا تزال على حالها بلا تجديد ولا تطوير، إلا في ما ندر. وهي برامج نظرية وغير تطبيقية في الغالب. فمدرّسو اللغة العربية، قبل انخراطهم في التدريس، غالبا ما يكونون من حملة إجازات جامعية في اللغة العربية وآدابها، وإما إجازات في التربية. ما درسوه في الجامعات من مناهج ومقررات لا يتعلق مباشرة بعملية التعليم وما تتطلبه من خبرات، وقد تكون قديمة وتقليدية.
يمكنني القول إن لدينا 3 أنواع من المعلمين:
• معلم يتقن اللغة العربية الفصيحة، ولديه مؤهلات في آدابها وصرفها ونحوها وقواعدها، لكنه يفتقد الطرائق الحديثة في أساليب تعليم اللغة العربية.
• معلم يمتلك الطرائق والأساليب الحديثة في التعليم، لكن لغته العربية ضعيفة وفقيرة، ولا يتكلمها إلا باللهجة المحكية.
• معلم لم يطّلع على المناهج والطرائق الحديثة، ولا يمتلك العربية الفصيحة.
في عملية تعليم اللغة العربية لا يكفي أن يكون المعلم حائزا ولو بجدارة عالية إجازة جامعية في اللغة العربية وآدابها أو في التربية. فتعليم اللغة، خصوصا للأطفال وتلامذة المرحلة الابتدائية والمتوسطة أو الإعدادية، يتطلب إعدادا خاصا وتخصصا محددا ومستقلا. وذلك في كيفية تعليم القراءة وتعلُّمها للأطفال، وفي كيفية تدريس المنحى الصوتي للغة. فعلم القراءة تطوّر كثيرا اليوم. وهناك أدب الأطفال الواسع والمنتشر بكثافة، الذي يتطلب إدخاله في عملية تعليم الطفل. التعامل مع الأطفال والمراهقين في عملية التعليم يحتاج إلى اختصاصات تطبيقية متنوعة. وعموما لم نلاحظ علاقة جيّدة أو إيجابية بين التلامذة والمدرّسين.
هناك أيضا مسألة تدريب المعلمين الأساسية، وهي غائبة تماما في بعض البلدان العربية. وفي حال حضورها في بلدان أخرى، نجد أنها ضعيفة. الدول العربية التي تستثمر في مجال تدريب المعلمين، تحتاج إلى المزيد في المجال العملي والتطبيقي. فأن يتدرّب المعلم نظريا لا يكفي، فالجانب التطبيقي، أي التدريس التجريبي في المدارس، أساسي وضروري. لا يكفي مثلا أن يعرف المدرّس أنواع الذكاء المتعددة معرفة نظرية. المهم أن يعرف كيف يمكن استثمارها عمليا. القراءة وأنواعها وخبراتها تحتاج إلى معلم يطوّر مداركه وخبراته، وكذلك في مجال تعليم الكتابة. والمدرّس الجيد هو من يستطيع استخدام المعلوماتية في التدريس، ويجيد كيفية الحصول على المعلومة وتوصيلها وتوظيفها في سياق محدد أثناء عملية التعليم. وهو أيضا من يستطيع الدخول إلى قاعة التدريس وضبط التلامذة من دون أن يرفع صوته.
تنوع اللهجات لا يلغي قط أننا أبناء لسان أو لغة واحدة، أو حقيقة لغوية واحدة
تحضر في السياق مسألة اللغة الفصحى ولهجاتها في الكلام داخل قاعات التدريس. غالب الظن أن اللهجات المحكية هي السائدة في هذا المجال. لكن كيف يمكن التوفيق بين لغة البرامج المكتوبة بالفصحى، وبين عملية التواصل التي تحدث بالمحكيات في الصفوف؟
الحديث عن ازدواجية العربية ليس جديدا ولا معاصرا، بل هو حاضر منذ خمسينات القرن العشرين وستيناته. وقد تحدث عنها طه حسين وسعيد عقل على سبيل المثل. واليوم يثيرها العالم اللغوي المغربي عبد القادر الفاسي الفهري، الذي لديه مؤلفات في الموضوع.
وقد قمت مع مجموعة باحثين بمراجعة منهجية لمئات المقالات والدراسات في الموضوع عينه. وربما عليَّ أن أشير، بداية، إلى أن لغات كثيرة تشبه لغتنا العربية في ازدواجها بين الكتابي والمحكي، ولو بنسب ومقادير متباينة. حتى اللغة الإنكليزية، هناك نسختها الأميركية والأخرى البريطانية المختلفتان عن النيوزيلندية. أما اللغة العربية، بحكم أمدائها الجغرافية والديموغرافية الواسعة، فلديها ذاك التنوع الكبير في لهجاتها المحكية الثرية. وهنالك أيضا التراث العربي الكبير بتنوع مدارسه اللغوية، كالبصرية والكوفية، وقبلهما لهجات القبائل الكثيرة… إلخ.
لا أظن أن المشكلة القائمة بين اللغة العربية الفصيحة واللهجات العامية الكثيرة، ساخنة ومعوّقة، لا في عملية التعليم ولا في سواها. ويمكن في هذا المجال تعريف الناطق بالعربية بأنه ذاك الذي يتقن، إلى حدود معينة، لغته الفصيحة الأم، وإلى جانبها لهجة محكية معينة. وهذه الأخيرة لا تختلف من بلد عربي اللسان إلى آخر، بل من منطقة إلى أخرى في البلد الواحد. لكن هذا التنوع كله لا يلغي قط أننا أبناء لسان أو لغة واحدة، أو ما أسميه حقيقة لغوية واحدة.
أظن أن المشكلة ليست في هذه الإزدواجات، بل في مكان آخر: تعليم اللغة العربية السيئ. والأرجح ليس تعليم اللغة فحسب، بل تعليم العلوم والرياضيات. زد على ذلك المسألة التي تحدثنا عنها أعلاه: إعداد المعلمين وتدريبهم.
————————————-
ترجمة النصوص المقدّسة: جسور بين الثقافات أم جدران عازلة؟/ سامر أبوهواش
آخر تحديث 26 مارس 2024
يعتبر فالتر بنيامين، في مقالته الشهيرة “مهمة المترجم” (1923)، أن المترجم الرديء، هو ذلك الذي “ينقل المعلومات” فحسب من لغة الأصل إلى لغة أخرى، معرّفا الترجمة الرديئة، تاليا، بأنها “نقل غير دقيق للمحتوى غير الجوهريّ”، ويقصد بذلك الفروقات الصغيرة الكامنة في اللغة الأصلية، أو في ما وراء تلك اللغة. ويتبدّى ذلك أكثر ما يتبدّى، بحسب بنيامين في مقالته التي كُتبت كمقدمة لترجمة شعر بودلير إلى الألمانية، أن هذه المسألة تتجلّى أكثر ما تتجلّى في ترجمة الشعر. تلك التي وجدها الجاحظ في كتابه “الحيوان” مستحيلة، إذ اعتبر أن المعجز في الشعر العربي يتمثّل في أوزانه وقوافيه، وكيف يمكن نقل ذلك من العربية إلى اليونانية مثلا دون أن يفقد الشعر عنصره المعجز ذاك. وإذ يشير الجاحظ إلى ضرورة إلمام المترجم باللغتين إلماما متساويا، أي أن يكون المترجم مجيدا للغتين، المنقول إليها والمنقول منها، إجادة تامة، فإنه في الوقت عينه يشير إلى جوهريّة أن يكون المترجم عارفا بالموضوع الذي يترجم عنه من لغة إلى أخرى، عالما به، فلا يعقل أن يترجم أمور الطب والفلك والهندسة والحساب، من لا يفقه هذه العلوم، ويحيط بمبادئها ويعرف دقائقها، فكيف إذن بمن يترجم علوم الدين.
خيانة وأمانة
يقول الجاحظ: “هذا قولنا في كتب الهندسة والتنجيم والحساب واللحون فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن الله – عزّ وجل، بما يجوز عليه مما يجوز عليه، حتى يريد أن يتكلم على تصحيح المعاني في الطبائع. ويتكلم في وجوه الإخبار واحتمالاته للوجوه. وحتى يعرف ما يكون من الخبر صدقا أو كذبا وما لا يجوز أن يسمّى بصدق ولا كذب، وحتى يعرف اسم الصدق والكذب وعلى كم معنى يشتمل ويجتمع، وعند فقد أي معنى ينقلب ذلك الاسم وكذلك معرفة المحال من الصحيح وأي شيء تأويل المحال” إلخ.
فأيّ موضع أنسب للزجّ بكلمتي الكذب (التي تساوي في هذه الحالة ما اصطلح على تسميته بالخيانة) و”الأمانة” (الصدق) من نقل كلمة الله؟ بل إن الكلمة الأنسب لمقتضى الحال، التي وردت على سبيل المثل، في الحكم الذي قضى بإعدام الإنكليزي وليام تيندال في العام 1536 بسبب ترجمته الكتاب المقدّس من الإغريقية إلى الإنكليزية، كانت “الهرطقة”، تلك الكلمة الفضفاضة التي عُلّق الآلاف بسببها على الصليب، والتي توازي في الحكم الآنف الذكر، بين الترجمة والكفر، وتجعل منهما فعلا واحدا أو “جريمة” واحدة.
في حقيقة الأمر لم يعدم تيندال بسبب ترجمة الكتاب المقدس (العهدان القديم، غير المكتمل، والعهد الجديد)، بل إن تهمة الهرطقة التي وجهت إليه كانت بسبب عدم حصوله على ترخيص من السلطات الكنسية للقيام بالترجمة، وأن ترجمته جاءت حافلة بالأخطاء إلى درجة أن “البحث عن أخطائه يعادل البحث عن المياه في البحر”، بحسب وصف معاصره توماس مور، وقد حظرت الكنيسة الكتاب في 1526، قبل اتهام صاحبها بالهرطقة في 1529. أما السبب غير المباشر فهو ما يمكن وصفه بالكيدية السياسية، إذ رفض تيندال تأييد فسخ زواج ملك إنكلترا هنري الثامن من كاثرين الأراغونية، لصالح الزواج من آن بويلين. وهو سبب ربما يودي به إلى الاغتيال، لكنه لا يؤدي به بالضرورة إلى الحرق على الصليب، وهو ما وفرت ترجمته للكتاب المقدس، سببا كافيا له، علما أن – للمفارقة – مور نفسه أعدم هو الآخر قبل تيندال بعام للسبب “السياسي” نفسه.
في هذا السياق يلفت الباحثان كيفن ويندل وأنتوني بيم في دراسة لهما (ضمن “كراسة أوكسفورد حول الترجمة الأوروبية العلمانية”، 2011)، إلى حادثة أخرى، قريبة زمنيا من حادثة إعدام تيندال، وهي إعدام الفرنسي إتيان دوليه عام 1545، أيضا بتهمة “سوء ترجمته” لمحاورات أفلاطون. وكان دوليه الذي اعتبر أن من يترجم النصوص حرفيا “مفتقر إلى الحكمة”، قد أوّل عبارة أفلاطون “بعد الموت لا يعود لك من وجود”، فأضاف إليها عبارة “ولن تكون شيئا على الإطلاق”، وهذا التأويل عدّته السلطات الكنسية في ذلك الوقت إنكارا للحياة الآخرة، وما يستتبعه ذلك من تكفير وإقامة لحدّ السيف.
عملية تبادلية
تؤكد هذه الوقائع وغيرها الكثير، أنّ التأويل كان منذ فجر انتقال النصوص بين اللغات والثقافات، جزءا أصيلا من عملية الترجمة، سلبا أو إيجابا، فالكلمات في ذاتها، حمّالة أوجه، والكلمة نفسها، معزولة عن أي سياق وأي تجاور، قد تعني أيّ شيء وكلّ شيء، بيد أن اجتماع سلسلة كلمات في عبارة أو أكثر، يمنح تلك الكلمات حياة أخرى، تنتظم فيه كل واحدة منها، في معنى ما، دون أن يعني ذلك البتة نهائية المعنى أو انتهاء التأويل. فكما يقول عبد السلام بنعبد العالي (“إعادة الترجمة لماذا؟، “المجلة” فبراير 2024)، فإن “من النصوص، حتى إن ظلت ‘سليمة’ عند نشرها ولم تمسسها يد محرفة، فإنها تعرف تحولات كبرى في فهمها وتأويلها والقيمة التي تُعطى إياها، بل إن منها ما لم يفتأ يعرف قراءات متجددة”، ويضيف: “لذا علينا أن نستبعد الاكتفاء بالقول إن تعديل الترجمات يرمي أساسا إلى تجاوز “أخطاء” الترجمات السابقة. ربما ينبغي لفهم تحول الترجمات أن نتخلى عن الصواب والخطأ معيارين لجودة الترجمة أو رداءتها. فليست هناك ترجمات خاطئة وأخرى صائبة. ربما يمكننا أن نكتفي بالقول في هذا الصدد، إن هناك ترجمات غير ملائمة، وأخرى أكثر ملاءمة”.
فالترجمة هي، في نهاية المطاف، عملية تبادلية بين المترجم والمتلقي، مثلما أن الكتابة بأشكالها المختلفة، عملية تبادلية بين الكاتب والقارئ. هذه الخاصية هي التي تجعل النص عملا في عملية تأويل لا تنتهي، لأن قراءته أو بالأحرى قراءاته لا تنتهي، ويظل النص الأصلي، وذلك المترجم، ناقصين، من دون عملية التلقي. فمنذ اللحظة التي تبدأ فيها رحلة النص من لغة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى، ومن عصر إلى عصر، يغدو شأنه شأن النص الأصلي، مقروءا بلغته الأولى، متغيرا بتغير متلقيه وظروف التلقي. وهذا ربما ما يوجب الحذر عند الكلام على “صحة” الترجمة و”خطئها”، وهذا بالضبط ما رأيناه في النقاشات المستفيضة حول أولى ترجمات الكتاب المقدس، سواء تلك التي اعتمدت مصادر عبرية أو إغريقية أو لاتينية، أو استندت إلى لغات أوروبية بينية، حيث ينتقل النقاش من كونه لغويا لسانيا، إلى كونه لاهوتيا وأحيانا سياسيا.
كلمة الله
في العودة إلى اللغة والمقدّس، ظلّ النص الديني ردحا طويلا من الزمن هو الدافع الأول إلى الترجمة، بداية من ترجمة التوراة إلى اليونانية، ثم إلى اللاتينية، مرورا بترجمة العهد الجديد، ثم القرآن الكريم، وغير ذلك من الكتب المقدّسة. واللافت أنه في حين يراد من تلك الترجمات أن تنشر النصّ المقدّس خارج حدوده اللغوية المعهودة، إلى أقوام ناطقة بلغات أخرى، وبالتالي إيصال “كلمة الله” وربما التبشير بها، في تلك اللغات، فإن فعل الترجمة نفسه، حين يتعلق الأمر بتلك النصوص، يمكن عدّه أحيانا، شكلا من إقامة الحدود بين الأديان، بالتوازي تماما، مع تلك الجسور المراد تشييدها بين البشر. المسألة تغدو أشدّ إشكالية حين نحصر الأمر في نطاق الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، حيث تعمل بعض الترجمات ضمن المنطق والسياق نفسه، وبالتالي تؤدّي الغرض نفسه الذي كانت تلك الديانات تعمل به وتؤديه، فنراها تخلق التمايزات وتعزز الاختلافات، بدلا من أن تبحث عن المشتركات حيث توجد.
نلاحظ في هذا السياق أن ترجمة التوراة مثلا، لم تكن في أساسها تستهدف الثقافات الأخرى، بل تقصد أتباع اليهودية، المنتشرين في الأرض، ولا سيما في أوروبا، ومن هنا كانت الترجمة إلى اللاتينية على أيدي رجال دين يهود، والأمر عينه ينطبق على الإسلام الذي تستهدف ترجمته في الغالب، لا سيما الرسمية منها (بالحري شبه الرسمية لأنه ليس هناك ترجمات رسمية)، المسلمين أنفسهم في ثقافات أخرى لا تتحدّث العربية، هذا مع العلم أنها تشترك مع المسيحية، على عكس اليهودية، في فكرة التبشير ونشر الديانة إلى أقوام لا تتبعها أو تتبع ديانات أخرى. لعلّ أوضح مثل على ذلك هو ترجمة لفظ الجلالة نفسه. وسأتوقف حصرا عند الترجمة من العربية إلى الإنكليزية، دون الغوص في الجذور الأنثروبولوجية واللغوية والثقافية في اليهودية والمسيحية، امتدادا من العالم القديم والعالم الإغريقي، إلى يومنا.
ترجمات القرآن
أول ترجمة مؤرخة للقرآن إلى الإنكليزية (بعد ترجمات سبقتها إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية والروسية والإسبانية) هي ترجمة الأسكتلندي ألكسندر روس (1590 – 1654) ولم تكن مباشرة عن العربية، بل جاءت من ترجمة أندره دي ريير، قنصل في الإسكندرية، إلى الفرنسية. بصرف النظر عن نظرة روس أو من سبقوه أو تلوه إلى ترجمة القرآن، منذ القرن الثاني عشر للميلاد حتى القرن العشرين، إلى الإسلام نفسه، وهي نظرة يدخل الكثير منها في باب “اعرف عدوك”، أو في باب المحاججات اللاهوتية، أكثر مما تشكل مسعى حضاريا لبناء الجسور. بصرف النظر عن ذلك، ما يهمنا هو ترجمة لفظ الجلالة، وهو يرد في نسخة روس وفقا للكلمة الإنكليزية (الألمانية الجذور) God، ولا يرد منقحرا (النقحرة أو “الحرفنة”، وهي النقل الصوتي للغة ما إلى لغة أخرى) كما بتنا نجد في ترجمات عديدة لاحقة، أي Allah.
كذلك الأمر بالنسبة إلى أول ترجمة مؤرّخة للقرآن الكريم من العربية إلى الإنكليزية يقوم بها مسلم، بحسب مسرد ترجمات القرآن المتوافر على الشبكة العنكبوتية، وهو هندي يتبع المذهب الأحمدي يدعى محمد عبد الحكيم خان ونشرت في 1905، وهي لا يعتدّ بها كترجمة، سواء من حيث اتساعها وحجمها، فهو لا يترجم القرآن الكريم كاملا، أو من حيث جودتها. إلا أن ما يهمنا في ترجمته تلك، أن هدفها الضمني كان الردّ على الديانات الأخرى، سيما المسيحية. وفي مقدمته القصيرة لا يغفل “المترجم” الربط بين اللغة والمقدّس، في إشارة دالة إلى “استحالة” ترجمة النص القرآني فعليا: “إن تسامي لغة القرآن وعمقها، ليس ممكنا لأي إنسان التعبير عنها تماما بأي لغة بشرية، إلا إن قاد الوحي كلّ كلمة من كلماته”. لينتقل في ترجمته (بالأحرى تفسيره) للفاتحة، إلى تعريف “أل التعريف” العربية، وذلك ليس في معرض إثباته كلمة Allah بدلا من God كما نرى في كثير من المحاججات الراهنة، بل في معرض شرحه المجمل للآية الثانية “الحمد لله رب العالمين” التي يترجمها إلى All the Praises are for Allah. وفي حين يعتبر أن إثبات الكلمة المنقحرة Allah لا تحتاج إلى تعليل فإنه يعللها في “الحمد لله” all Praises: “الكلمة العربية (أي الحرف) الـ تتضمن الشمولية وهي تشير إلى جميع القوى السامية والصفات التي تتشكل منها الألوهة، والتي لا يستحق أن يوصف بها إلا الله”. ثم يدلي بموقف ديني يعلل سبب إسباغه كلّ هذه القدسية على كلمة “الحمد” بالقول: “في الطبيعة الفاسدة وحدها، وفي الضمير المنحرف، والثقافات الخرافية، ينسب المرء قوى عليا إلى أي كائن، سواء أكان إنسانا أم شمسا أم نجما أم قمرا أم صورة”. ليكون ذلك بمثابة ردّ ضمني على المسيحية، وسواها.
Lina Jaradat Lina Jaradat
وقد جاءت الترجمة التالية من مسلم في العام 1911، بحسب مصادر، أو 1912 في مصادر أخرى، على يد رجل دين من البنغال (بنغلادش اليوم) يدعى ميرزة أبو الفضل، ومن الواضح أنه كان يتقن العربية والإنكليزية، وإن شابت ترجمته، على غرار جميع من ترجموا القرآن قبله، أخطاء ومواطن ضعف كثيرة، يعترف بها المترجم، ويعزو بعضها إلى “شيطان المطبعة الهندية”، أي إلى الأخطاء المطبعية، وإن كانت المسألة تتجاوز ذلك بكثير. إلا أنه يبقى المهم أن الرجل قرّر ترجمة لفظ الجلالة إلى كلمة God الإنكليزية التي تدلّ عليها، ولم يختر كما وجدنا قبله وبعده، وإلى يومنا، استبدالها في أحايين كثيرة بكلمة Allah، ولا أعرف ما الذي دفعه ومن قبله إلى هذا الخيار، إلا أنه بدا على الأرجح الخيار العقلاني والمنطقي الوحيد.
المسلمون غير العرب
يبدو لافتا أن جميع ترجمات القرآن إلى الإنكليزية، وهي تربو على العشر، حتى النصف الأول من القرن العشرين، أنجزها مسلمون غير عرب من الهند أو ماليزيا أو باكستان. وهناك ترجمتان أنجزهما بريطانيان، أحدهما اعتنق الإسلام، لتأتي الأولى من شخص “عربي” (بالمعنى الحضاري والجغرافي)، في 1956 على يد العراقي اليهودي نسيم يوسف داود (1927 – 2014)، وهي الترجمة التي لا تزال الأكثر مبيعا بين ترجمات القرآن إلى الإنكليزية (70 طبعة إلى وقتنا هذا)، وقد اشتغل داود عليها بعد إنهاء دراسته بموجب منحة من الحكومة العراقية في 1945، حيث درس الآداب الإنكليزية في جامعة لندن، ليدعوه ناشر “بنغوين” السير ألن لاين إلى ترجمة “ألف ليلة وليلة” (1954) ثم ترجمة القرآن الكريم.
بعد ذلك تأتي نحو 17 ترجمة للقرآن إلى الإنكليزية جميعها من المناطق الجغرافية الآنفة الذكر، وأنجزها مسلمون من تلك البلاد (أن المسلمين العرب 20 في المئة من مسلمي العالم)، حتى صدرت ترجمة إنكليزية أنجزها عرب في لبنان عام 1980، بتكليف من المجلسين السني والشيعي، وقد أنجزته مجموعة من أساتذة الجامعة الأميركية ببيروت، بمشاركة وإشراف البروفسور محمد يوسف زايد (توفي في 1994)، التي يرى بعضهم أنها ليست إلا تنقيحا للترجمة التي أنجزها نسيم يوسف داود، وأن الترجمة الجديدة لا تحلّ حتى بعض المعضلات الترجمية والغموض الذي انطوت عليه في بعض المواضع.
يطول الحديث بعدئذ عن الترجمات المتتالية للقرآن الكريم إلى الإنكليزية (وهي اللغة الغالبة بين اللغات التي ترجم إليها والتي تتجاوز المئة ترجمة)، مع ملاحظة غلبة ترجمة غير العرب، على الناطقين بالعربية، وملاحظة أخرى هي أنه ليس هناك ترجمة عربية “رسمية” للقرآن، بمعنى أن تتبناها بوضوح مؤسسة دينية كبرى، ربما انطلاقا من فكرة أن كلّ ترجمة للقرآن ما هي في نهاية المطاف سوى اجتهاد شخصي للمترجم/المترجمين، ولا يمكنها أن تكون مطابقة لأصالة النص بلغته العربية، بل إننا نجد أن ثمة فتاوى صدرت عن علماء دين كبار تتعلق بمشروعية ترجمة القرآن من عدمه، وجميعها تتضمن هذا التحفظ.
وإذ تتطلب أي خلاصات جادة حول هذه الترجمات، دراسات معمقة، خصوصا أننا أمام أنماط متعددة من الترجمة، منها ما يسمّى تفسيرا ومنها موجزا، ومنها ترجمة نصّية غير شارحة، فإننا نجد أن مبدأ “النقحرة” لا يزال قائما في ترجمة القرآن إلى الإنكليزية، منذ فجر تلك الترجمات وإلى وقتنا هذا، وهو عامل مشترك في أغلب الأحيان بين ترجمات من يمكن وصفهم بالمستشرقين، ومن هم مسلمون.
لفظ الجلالة
وفي ما يتعلق بلفظ الجلالة “الله” على وجه التحديد، فإننا نجد من يحاجج بأن تثبيت لفظAllah في ترجمات القرآن إلى الإنكليزية، عوضا من كلمةGod إنما هو للتمييز عن الديانات الأخرى (المسيحية خصوصا) بأنه ليس “أي إله” بل الله الواحد الأحد، وهذا دور ألـ التعريف بحسب تلك الترجمات، وهو الدور نفسه في نقحرة كلمة “الرب” Alrabb في بعض منها.
واللافت أن الترجمات الاستشراقية التي تعتمد الأسلوب نفسه، فكأنما تتبنّى هذا المنطق، وإن بطريقة مقلوبة، فعبر إثبات لفظAllah يبدو أن الحديث يدور حول إله آخر، إله خاص – وربما غريب – بهذه المجموعة البشرية التي تعتنق الإسلام، وليس الرب أو الإله نفسهGod. ومثل هذا الاستخدام يتخذ شرعيته من استخدام المسلمين أنفسهم له، وفي الحالين فإن النتيجة الإيحاء أو الإيهام بأننا لسنا أمام الرب نفسه، وهو ما يتجلى بخفّة أكبر في الإعلام، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويساهم في خلق هوّة ما زالت تتسع، على الرغم من كلّ مساعي التقريب، بين الديانات والثقافات، وتجد ترجماتها صراعا حول من يعبد الله بالطريقة الصحيحة، ويصلي له ويتقرّب منه (عبر النصوص الدينية) بالطريقة الصحيحة.
في حرب غزة الأخيرة انتشر مقطع فيديو لجندي مقبل على تفجير مسجد في إحدى مدن القطاع، وهو يخاطب جمهوره بالعبرية قائلا إنه لن يذكر في هذا المكان بعد اليوم إلا دعاء مباشرة الصلاة العبرية “اسمعي يا إسرائيل”، بدلا من الآذان الإسلامي أو عبارة “الله أكبر الله أكبر”” التي تصدح من مآذن تلك المساجد. فإذا كان “الضياع في الترجمة” قد ساهم في ولادة تيارات إسلامية متشدّدة، جمهورها وحطبها من غير الناطقين بالعربية (وهم الغالبية) كما رأينا مع تجربة “داعش” أو “القاعدة”، تنظر إلى اللغة بوصفها رموزا طقوسية، لا ناقلة للمعاني والأفكار، أي إذا كان هذا الواقع معيشا وملموسا داخل الإسلام نفسه، فلا ينبغي أن نتوقع أقلّ من ذلك بين الأديان السماوية المختلفة.
——————————–
المجلة




