هل الذكرياتُ حقيقةٌ أم تخييل؟/ صوفي مَكْبين
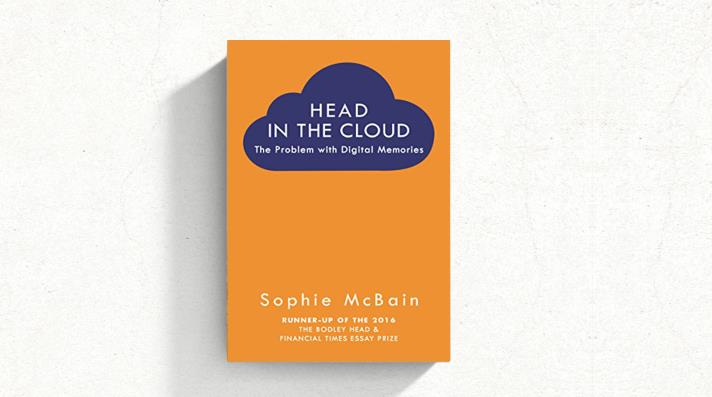
6 يوليه 2024
ترجمة: لطفية الدليمي
واحدةٌ من أقدم ذكرياتي عن بواكير طفولتي لم تزل محفورة في ذاكرتي لم تغادرها أبدًا. كانت تلك الذكرى المبكّرة تختصُّ بيومي الدراسي الأول في المدرسة، حيثُ كنتُ عُرْضة لشتى صنوف المضايقة بسبب حديثي بلهجة هولندية مميزة. توجهتُ باللوم حينها إلى والدتي بسبب هذا الإذلال الذي لم أكن أستحقه، وقفلتُ راجعة من المدرسة إلى البيت وأنا أغلي حنقًا على والدتي، وحالما رأيتها أخبرتها بنبرة توبيخية قاسية: “إنها Three يا أمّي، وليست Tree، كما نقولها في أحاديثنا المنزلية”. الأمر الغريب في هذه الذكرى المدرسية المبكّرة أنها ربما كاذبة لا تقول الحقيقة الناصعة. تقسمُ أمي بقوة أنّ بطل الحكاية صاحب العبارة الأخيرة هو أخي، ولستُ أنا!!.
هذا النوع من الإرباك والخلط شائع بين العوائل. عندما تحكى القصص وتُعادُ روايتها مرات ومرّات، فستكون لها في نهاية الأمر حياة خاصة بها لا علاقة لها ــ ربما ــ في قليل أو كثير بالواقعة الأصلية. التفاصيل تخبو وتتضاءل، ومن ثمّ تصبح عرضة للتغيير مع إعادة الحكي، وحينها سيكون أمرًا طبيعيًا للغاية أن يحلّ اسم طفل محلّ آخر، أو أن يحصل خلط بين حكاية مألوفة لتكون بديلًا عن ذكرى شخصية. ذكرياتي الشخصية تبدو لي واضحة ساطعة في إطارها العام؛ لكنّ التفاصيل تغدو أكثر ضبابية عند إخضاعها للامتحان الدقيق. في المثال السابق الذي حكيتُ عنه بشأن أمّي ثمّة أسئلة دقيقة لا أملك جوابًا لها: ما الموضع الذي كانت تقف فيه أمّي عندما تحدّثتُ معها بشأن المضايقة التي حصلت لي في يومي المدرسي الأول؟ وما الذي كانت ترتديه؟ الامتحان الدقيق قد يقود إلى تكذيب حكايتي كلها، أو جوانب منها في الأقل.
كنتُ في الرابعة حينها، وكما نعرف فإنّ أغلب الاطفال لا يستطيعون تذكّر أي شيء يخصُّ حيواتهم قبل عمر الثالثة، أو الرابعة، وتلك ظاهرة تدعى فقدان الذاكرة الطفولي/ infantile amnesia. اقترح العلماء أنّ هذا النسيان الطفولي المبكّر يرتبط بوجهيْن من أوجه التطوّر الإدراكي: الأوّل مفاده أنّ تعزيز الذاكرة الخاصة بالسيرة الذاتية للفرد يحتاجُ اللغة؛ إذ من العسير على الفرد الاحتفاظ بذكرى ما وهو يفتقد الكلمات المناسبة للتعبير عنها؛ ولمّا كانت الوسائل اللغوية وتعقيداتها لم تتطوّر إلى حدّ مقبول لدى الأطفال، فسيكون نسيان الذكريات الأولى نتيجة منطقية متوقعة. الأمر الثاني أنّ تذكّر الوقائع الماضية يتطلّبُ حسًا متماسكًا بالذات Self؛ بمعنى القدرة على التمييز بين”ما حدث”، و”ما حدث لي أنا”، وهذا ما لا يحصل في العادة لدى الأطفال؛ فهم لا يميّزون في العادة بين الوقائع العامة والوقائع الشخصية. بعبارة أخرى: لكي نتذكّر حياتنا السابقة نحنُ في مسيس الحاجة لأن نكون قادرين على وضعها في شكل سردي، وهذا الجهد السردي يستلزم فرض نظام ومعنى على فوضى وجودنا البشري عبر تحويل السردية إلى حكاية أولًا، ومن ثمّ موضعتنا كشخوص مركزيين في سردياتنا. عندما نفعل هذا فحينها ــ وحينها فقط ــ نعلنُ عن انبثاقنا الوجودي في العالم.
خلال السنوات الست بعد أن أصبحتُ أمًا، حرصتُ على مراقبة هذه العملية عن كثب وبتدقيق كبير. اثنان من أطفالي الثلاثة كانا أصغر بكثير من أن يتذكّرا واقعة صغيرة حدثت لهما وهما في هذا العمر المبكّر، وفي المقابل فإنّ طفليّ الأكبر عمرًا يحبان التطلّع في صورهما عندما كانا رضيعيْن بنفسيهما من غير مساعدة أحد، وفي هذه الأثناء يستمتعان بسماع حكايات عنهما وهما رضيعان بعدُ. ربما مع الزمن قد يحسبان هذه الحكايات بعضًا من ذكرياتهما الشخصية، وحتى لو لم يفعلا فستكون هذه الحكايات وسيلتهما المساعدة في تشكيل ذكرياتهما اللاحقة بشأن حياتيهما المبكّرتين، وقد يميلان إلى إضفاء قدر من التضخيم الدرامي على محكياتهما السردية بشأن طفولتهما المبكّرة، أو في سنوات تليها.
يمارسُ الآباء سلطة هائلة في تشكيل ذكريات أطفالهم؛ فهُمْ خالقو الحكايات الأولى التي يسمعها أطفالهم بشأن عمّن يكونون (الأطفال)، ومن أين قدموا إلى هذا العالم. في الغالب تكون لهذه الحكايات الأولى تأثيرات راسخة ممتدة في تشكيل شخصيات الأطفال والتعريف بكينوناتهم وهوياتهم الذاتية حتى نهاية أعمارهم. قد تكون هذه السرديات التي تُحكى للأطفال أحيانًا قريبة من الواقع لا تخالفه كثيرًا، وفي أحيان أخرى قد تكون اختلاقات تخييلية خالصة لا علاقة لها بالواقع، أو الحقيقة المجرّدة. في دراسة بحثية صغيرة ــ لكنها عظيمة المفاعيل في نتائجها ــ أجرتها عالمة النفس إليزابيث لوفتس/ Elizabeth Loftus عام 1995، كشفت الدراسة عن أنّ قريبًا لأحد المشاركين الأربعة والعشرين الذين شملتهم الدراسة عندما أنيطت به مهمّة رواية قصة تخييلية (لكنها معقولة إلى حد بعيد) تخبرُ أحد المشاركين كيف تاه في أحد المولات (مراكز التسوق الكبيرة) وهو طفلٌ صغير، فإنّ ستّة من المشاركين الأربعة والعشرين شكّلوا لهم ذكرى كاذبة خاصة بهم تختلف عن الأصل إلى حدود متفاوتة. نتيجة التجربة أننا نساهم في صناعة ذكرياتنا وإعادة تكييفها وتعديلها بين حين وآخر، ولسنا متلقّين سلبيين لها.
دراسة الذكريات الكاذبة، أو الملفّقة، أو الزائفة، أو المعدّلة كثيرًا، صارت مبحثًا له دافعيته السياسية الملحّة؛ فقد أشعلت هذه الدراسة جذوة النقاشات المعمّقة حول قدرة المعالجين النفسيين على زرع ذكريات محدّدة في عقول أناسٍ مشخّصين بشأن تعرضهم لإساءة تعامل جنسي في الطفولة، أو إقناع بعض النساء أحيانًا بأنّهنّ كنّ ضحية وقائع اغتصاب أو مشاركات في جنس جماعي بإرادتهنّ الذاتية. عندما أحاججُ بأنّ الذكريات الشخصية هي أقربُ لأن تكون تخييلًا من أن تكون حقيقة فأنا أفكّرُ قليلًا في الوسائل التي يمكن بواسطتها تعديلُ ذكريات الآخرين، والتأثير فيها بكيفية يشاؤها من له منافع محدّدة في هذه الفعالية التعديلية. الأمر الأكثر أهمية وإثارة لي هو طبيعة الذكريات بصورة عامة. العلم الكامن وراء الذكريات يبدو واضحًا إلى حدود بيّنة: عقولنا لا تعملُ كما الأقراص الصلبة، أو المسجّلات الفيديوية. الذكريات ليست كينونات مادية مُخزّنة في مكان ما من الدماغ البشري؛ بل هي سرديات إبداعية لإعادة تمثل وقائع حصلت لنا، وهي لا تفتأ تتغيّر بصورة ثابتة ومستديمة لأننا نشاء لها أن تتغيّر.
نحنُ نعدّلُ في ذكرياتنا الماضية بحيث تصبح أكثر قدرة على تلبية إحتياجاتنا الحاضرة.
أشارت دراسة أخرى بشأن الذكريات الومضية flashbulb Memories حول واقعة 11 أيلول/ سبتمبر إلى حقائق تؤكّد الحجم التخييلي في ذكرياتنا. نعرفُ من خبراتنا التاريخية المتراكمة على الصعيدين الشخصي والجمعي أنّ ذكرياتنا الومضية تختصُّ بما نشهده من وقائع رهيبة، وفي الغالب تحتفظ ذاكرتنا بتفاصيل كثيرة من هذه الوقائع بسبب هول وبشاعة المشاهد؛ لكن برغم هذا فقد وجدت الدراسة أنّ ما يقاربُ 40% من الأشخاص الذين شهدوا واقعة 11 أيلول الرهيبة غيّروا عقب سنة من الواقعة أجزاء ليست قليلة من تفاصيل الواقعة بالمقارنة مع التفاصيل التي سردوها عقب وقوع الحادثة مباشرة.
فضلًا عن فعاليتها التكييفية والتعديلية، تميلُ ذكرياتنا إلى أن تعزّز لدينا كلًا من تضخيم الذات/ Self-aggrandising، وخدمة الذات/ Self-serving. أشارت دراسة إلى أنّ الطلبة يميلون إلى تذكّر الموضوعات التي نالوا فيها درجات عليا (A) أفضل بكثير من الموضوعات التي نالوا فيها درجات دنيا (D). وجدت دراسة أخرى أنّ الطلبة عندما يحققون أداء أفضل من توقعاتهم في الامتحانات، فإنّهم يتذكرون القلق العظيم الذي عانوه كدالّة على تعظيم حسهم بالنجاح. عندما تكون ذاكرتنا جانحة لتزييف، أو تعديل الوقائع (بمعنى أن تكون غير دقيقة في سرد الوقائع الحقيقية) فإنها تخدمنا بصورة جيدة، لأنها تساعدنا حينئذ على تقمّص شعور البطل في قصة حياتنا الشخصية.
نعلمُ جميعًا كيف ستنتهي سيَرُنا الذاتية. سنموت، وسيموت مثلنا كلّ من نحب. في كتابه المثير علمُ الحكي القصصي/The Science of Storytelling، كتب وِلْ ستور/ Will Storr: “علاجُ هذا الرعب القاتل من الموت هو القصة. تعمل عقولنا على تشتيت وعينا بهذه الحقيقة المطلقة: الموت، موتنا وموت من نحب، من خلال ملء حيواتنا بأهداف تطفح بالأمل، وكذلك تزويدنا بالشجاعة اللازمة لتحقيق تلك الاهداف… القصص تعيننا على الحياة عبر منحنا وهم المعنى”. منذ أن ولِد أطفالي وأنا مسكونة بهاجس توثيق كلّ ما يختصُّ بمراحل طفولتهم المختلفة عبر التقاط أعداد لا نهائية من الصور، وتسجيل ملاحظات لا نهاية لها. أنا إذ أفعل هذا فإنما دافعي هو الخوف من النسيان، وهو ما أحسبه نوعًا من الحزن الاستباقي: إدراك فائق بالخسارة القادمة التي لا مهرب منها. هذا يعني ــ بين أشياء كثيرة ــ أنّ أطفالي (مثل حال أطفال كثيرين في عالم اليوم) سيدخلون طور بلوغهم وهم مزوّدون بشواهد توثيقية حول سنواتهم الأولى في الحياة أكثر بكثير ممّا لدى الأجيال التي سبقتهم. صرنا نحتفظ اليوم ومن غير جهد كبير بأرشيف رقمي توثيقي ضخم يمكن الرجوع إليه للتثبّت من صحّة الكثير من ذكرياتنا. لم تكن وقائع حياتنا الماضية متاحة لنا بهذا القدر من اليُسْر كما اليوم عبر منشوراتنا على منصات التواصل الاجتماعي، والرسائل البريدية الإلكترونية، والرسائل النصية، والصور المخزّنة، وتواريخ التصفّح؛ لكنّي برغم هذه المنافع الرقمية العديدة وجدت عند مراجعة بريدي الإلكتروني قبل ما يقاربُ العقديْن، أو عند مراجعة منشوراتي الفيسبوكية الأولى أنها أقرب لكائن فضائي من أن تكون لي أنا. أتساءل أيهما أقرب لذاتي الحقيقية: ذكرياتي المخزّنة في عقلي أم ذكرياتي المخزّنة في وسيط رقمي؟
كيف أرى جوعي الممض لمحاولة توثيق كلّ ما يختصُّ بحياة أطفالي؟ هل أقيّدُ قدرتهم وألجمها إذا ما أرادوا كتابة تواريخهم الشخصية في سنوات لاحقة؟ نحنُ في العصر الرقمي لم نزل ككائنات بشرية نتوق إلى إعادة مساءلة تواريخنا الشخصية وكتابة ذكرياتنا عنها بالكيفية التي نشاء؛ لكنّ الحواسيب ــ بخلاف أدمغة البشر ــ لها القدرة على تقديم ذاكرة كاملة لوقائع حصلت لنا. في كلّ الأحوال من الأفضل أن لا نتناسى حقيقة وجود مساحة كبيرة من الحرية والقدرة لم تزل متاحة لنا في اختيار عدم التذكّر، أو في تعديل ماضينا، أو في تحويل حكاياتنا الشخصية إلى سرديات تخييلية نستطيع التعايش معها، وتستطيع هي جعل عالمنا مكانًا أفضل للعيش حتى لو كان عالمًا تكتنفه الأوهام لا الحقائق العارية.
قراءات إضافية:
– How the Mind Forgets and Remembers: The Seven Sins of Memory by: Daniel L Schacter (Mariner)
– Pieces of Light: The New Science of Memory by: Charles Fernyhough (Profile)
– The Memory Illusion: Remembering, Forgetting, and the Science of False Memory by: Dr Julia Shaw (Cornerstone)
(*) صوفي مكبين Sophie McBain: كاتبة مساهمة في تحرير مطبوعة New Statesman، كما تعمل محرّرة أخبار الشرق الأوسط في وكالة أنباء Associated Press. تقيم في القاهرة. لها كتاب منشور عام 2016 بعنوان:
Head in the Cloud: The Problem with Digital Memories
(**) الموضوع المترجم أعلاه منشور في صحيفة “غارديان” البريطانية بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2023 ضمن سلسلة The Big Idea الأسبوعية. العنوان الأصلي للمادة المنشورة باللغة الإنكليزية:
?Are memories fact or fiction
المترجم: لطفية الدليمي
ضفة ثالثة




