سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 06 شباط 2025
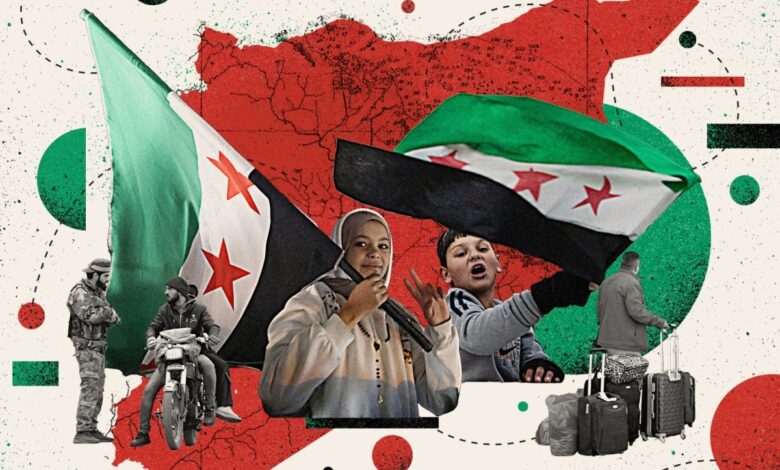
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
————————————–
سوريا الجديدة والمخاض العسير/ بكر صدقي
تحديث 06 شباط 2025
تسارعت، في الأسبوع الأخير، التطورات السياسية في سوريا ومن حولها إلى درجة بات من الصعب مواكبتها والإحاطة بها وفهمها. ففي التاسع والعشرين من الشهر الجاري اجتمع قادة غالبية الفصائل العسكرية في الشمال في إطار أطلق عليه «مؤتمر النصر» صدرت عنه مجموعة من القرارات، لعل أبرزها تنصيب أحمد الشرع «رئيساً للجمهورية العربية السورية» وحل الفصائل الثورية لتندمج في جيش وطني واحد تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة القائمة. القرارات الأخرى كانت من نوع تحصيل الحاصل كحل مجلس الشعب وحل جيش النظام المخلوع وجبهته الوطنية التقدمية.
لاقى توجه الشرع للمؤتمر المذكور بأول خطاب له منذ التحرير استياءً واسعاً في الرأي العام الذي سبق وكان يطالبه بإلحاح بخطاب يوجهه إلى الشعب يبين فيه توجهات السلطة التي يقودها ورؤيتها لمستقبل سوريا وتفاصيل العملية السياسية التي يمكن أن تقترحها للوصول إلى ذلك المستقبل. فلم يتأخر الرجل في الاستجابة لهذا المطلب، فألقى خطابه الثاني الذي وجهه إلى «كل السوريين والسوريات» وأكد فيه أن النصر تحقق بتراكم كل نضالات السوريين والسوريات منذ أول هتاف في المظاهرات السلمية ضد النظام المخلوع، وكل تضحياتهم وتضحياتهن، وبفضل كل الشهداء منذ حمزة الخطيب… في هذا الخطاب المقتضب بدوره حدد أولويات المرحلة الانتقالية التي بات يقودها بحكم منصبه الرئاسي، في السلم الأهلي ومحاسبة المجرمين بحق الشعب السوري، وتوحيد كل الأراضي السورية تحت سلطة الدولة، وتشكيل حكومة يتمثل فيها الجميع، وإنشاء هيئة تشريعية «مصغرة» ولجنة تحضيرية لمؤتمر «الحوار الوطني» الذي من المفترض أن ينتج عنه «إعلان دستوري»…
واستقبل الشرع في اليوم التالي لتنصيبه رئيساً للجمهورية أمير دولة قطر في دمشق، كأول رئيس دولة يزور سوريا الجديدة، ليقوم بعد ذلك بيومين بزيارتين إلى الرياض وأنقرة على التوالي.
بصورة متزامنة مع زيارته لتركيا تم تفجير سيارة مفخخة في مدينة منبج (في الشمال الغربي) في مجزرة بشعة تجاوز عدد ضحاياها عشر نساء إضافة إلى جرحى يفوقونهن عدداً. اتجهت أصابع الاتهام «بصورة بديهية» إلى «قسد» التي فقدت السيطرة على هذه المدينة منذ السادس من كانون الأول 2024، وذلك على رغم نفي «قسد» لهذا الاتهام. فقد تتابعت تفجيرات مماثلة في مدينة منبج منذ أواخر العام الماضي بعد سيطرة فصائل من «الجيش الوطني» التابع لتركيا على المدينة. بالتدقيق في تلك العمليات نرى أن المعلومات تشير إلى مجموعة غامضة تطلق على نفسها اسم «قوات تحرير عفرين» أو «غرفة عمليات غضب الزيتون» هي التي تتبنى تلك العمليات الإرهابية، في حين تنفي قيادة قسد أي علاقة لها بالمجموعتين. الشخص الوحيد الذي ثبتت علاقته بهما كردي تركي يحتمل أنه يتبع مباشرةً لقيادة حزب العمال الكردستاني التي تتخذ من جبل قنديل مقراً لها.
وقال أحمد الشرع في إحدى مقابلاته الإعلامية التي تم بثها بعد تنصيبه رئيساً لسوريا، إن المفاوضات مع قسد مستمرة، وتم التوافق على الأمور الأساسية وبقيت تفاصيل في طريقها إلى الحل، وامتنع عن إعطاء تفاصيل لإعطاء الفرصة للمتفاوضين للتوصل إلى حل مرضٍ للطرفين. ما دام الأمر كذلك من الغريب أن تلجأ قسد إلى عمليات إرهابية تزيد ضغط الرأي العام لحسم وضع قسد حرباً. المعقول أكثر أن تلجأ جهات لا تريد لهذه المفاوضات أن تصل إلى نتيجة إلى أعمال إرهابية للتخريب عليها. وأول ما يخطر في البال هو قيادة قنديل أو أحد جناحيه المشتبه بعلاقته مع إيران، من غير أن يلغي هذا احتمالات أخرى لجهات لا تريد لسلطة دمشق أن تستقر ولسوريا أن تتعافى، أو تسعى للضغط على الشرع أثناء وجوده في أنقرة لكي يتفق مع القيادة التركية في شن حرب مشتركة على قسد.
من جهة أخرى ثمة نوع من التقاطع بين بعض الضغوط الخارجية على السلطة في دمشق وضغوط قسم وازن من الرأي العام السوري بشأن وجوب احتضان السلطة الجديدة للتنوع الاجتماعي في سوريا، أو ما يسمى أحياناً بإقامة سلطة «شاملة لكل المكونات» هذا ما يسمعه الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني من كل الوفود الأجنبية التي تزور دمشق ومن قادة كل الدول التي يزورانها، في الوقت نفسه الذي يضغط فيه الرأي العام المحلي في الاتجاه نفسه وإن كان الأخير أكثر تطلباً من مجرد «تمثيل المكونات».
سواء في تصريحاته الإعلامية أو خطابيه، نلاحظ حرص الشرع على التجاوب مع هذه المطالب والضغوط، كما لاستثمار البيئة السياسية الإيجابية عموماً مع التغيير الذي حصل في سوريا في اتجاه تأمين شيء من الاستقرار للوضع الهش لسلطته كما لسوريا عموماً، من خلال تفادي الصدام مع أي جهة والحصول على أكثر ما يمكن من الدعم الشعبي والدولي معاً للمضي في العملية السياسية. ونلاحظ تجاوباً سريعاً مع كثير من الانتقادات والمطالب الشعبية. فلم تغب عن الملاحظة مخاطبته «السوريين والسوريات» ولا ذكره لعبارة «الجمهورية السورية» ثلاث مرات في كلمته المقتضبة جداً أثناء المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس التركي، ولا إقراره بـ«مفهوم معين» للديمقراطية في جوابه على سؤال من صحافيي «إيكونوميست» البريطانية، ولا حديثه الصريح عن كل من النظام الجمهوري و«المواطنة» في مقابلة أخرى. مع العلم أن هذه الإشارات من شأنها إثارة استياء بيئات معينة أبرزها تحالف الفصائل الثورية المسلحة التي لا تقبل بمفاهيم من هذا النوع.
يدرك الشرع، ولا بد، أنه يمشي على حبل مشدود يصعب مواصلة السير فوقه، معرّضاً لكل المخاطر. بتنصيبه رئيساً للجمهورية تزيد لديه إمكانية الاستقواء بالشعب على الفصائل، في حين أن تفويضه من الفصائل يمنح الأخيرة نوعاً من الوصاية عليه التي لا نعرف مدى ثقلها ومدى قدرته على التحرر منها ومن ثقل إيديولوجيتها. وخارجياً يمكن القول إنه حصل على «فترة سماح» من قوى إقليمية وازنة ومن المجتمع الدولي محكومة بما سيفعله في الأسابيع والأشهر القادمة. وسيبقى تعليق العقوبات الغربية على سوريا مؤقتاً إلى أن يتمكن من إقناع تلك القوى بأنه ماض في الطريق الصحيح.
كاتب سوري
القدس العربي
———————————-
أحمد الشرع والعلاقة مع تركيا/ عمار ديوب
06 فبراير 2025
أحرز وزير الخارجية أسعد الشيباني حضوراً إقليمياً مهماً، يتناسب مع الدولة التي يمثّلها، وأن سورية دولة أساسية في المنطقة. قاد أحمد الشرع ومطبخه السياسي إدارةً مميّزةً لملفّ العلاقات الخارجية، محاولين تصفير المشكلات مع الدول المحيطة بسورية، وانتهت بزيارة أول زعيم عربي دمشق، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مهنئاً، ومرسّخاً شرعية الشرع، وقد أسهمت زيارته هذه في ذهاب الشرع إلى السعودية وتركيا. وتعزّزت صفة الانتقالي للشرع بلقاء أمير قطر وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي أردوغان، وهذا يمثّل استعادةً لدور سورية الإقليمي.
لم تكن خطوات الفِكَر التي أعلنها الشرع بخصوص المرحلة الانتقالية دقيقة بما يكفي لشرعنته خارجياً وداخلياً، فهو اختير عبر الفصائل العسكرية، أي عبر الشرعية الثورية، وبدلاً من أن يُعلِن إعلاناً دستورياً ينظّم كيفية تشكيل الحكومة الانتقالية، والتمهيد للمؤتمر الوطني العام، أي عبر الشرعية الدستورية، كُلّف بتشكيل مجلس تشريعي مؤقّت. وبذلك، يتحكّم الشرع في كل خطوات المرحلة الانتقالية، وقد قلّص من أهمية المؤتمر الوطني بجعله مؤتمراً للحوار الوطني، أي لم يعد المؤتمر مصدرَ الشرعية، بل وظيفته المشاورات والنقاشات العامّة. إن هذه الفِكَر لا تستجيب لجوهر القرار 2254، وفيها استبعاد (ولنقل تهميش) لدور الفعّاليات الاقتصادية والثقافية والسياسية في المرحلة الانتقالية وكيفية السير بها. كان تعزيز شرعيته يقتضي، السير بخطوات الشرعية الدستورية، وتحديد موعد زمني لكلّ منها، والانفتاح الواسع تجاه الشخصيات الوطنية الفاعلة، للنقاش في القضايا المتعلّقة بإصلاح سياسات الدولة ومختلف مؤسّساتها. هنا نقطة ضعف شديدة، ستستفيد منها الدول المحيطة، ومنها تركيا والسعودية، ولا سيّما أن المرحلة الانتقالية في سورية ستطول أربع سنوات أو خمساً، كما أشار الشرع.
تعاني الإدارة الجديدة العقوبات المالية والأمنية الأميركية ضدّ النظام السابق، وللعقوبات تأثير حاسم في الحدّ من الدعم الإقليمي للإدارة، وعلى كارثية الوضع الداخلي المتفاقم. مع ذلك، رفعت هذه الإدارة بعض العقوبات ستّة أشهر، والاتحاد الأوربي رفع بعضها سنةً. زيارة أمير قطر، وزيارتا الشرع السعودية وتركيا، هي (في جانب منها) للتباحث في كيفية المساعدة في رفع العقوبات ومسألة إعادة الإعمار، وإذ كان هناك ضرورة كبيرة لإبعاد الشخصيات المُعاقَبة من إدارة الشرع، وعدم تمثيلها في أيّ مناصب سيادية، فهناك ضرورة للاستعانة بجوهر القرارات الدولية الخاصّة بسورية، كقراري مجلس الأمن 2254 و2118، للتخفيف من الضغطين الإقليمي والعالمي. إن خطّة الشرع، وانطلاقاً من تكليف الفصائل له قيادة المرحلة الانتقالية، لا تتوافق مع هذه القرارات، ولكن إعلان حكومة من خارج الإدارة، وأن تكون تمثيلية لكل السوريين، سيساعد في العودة إلى الشرعية الدستورية، وضمناً لو ذهب نحو التمهيد للمؤتمر الوطني العام مرجعيةً للشرعية المذكورة، وهذا سيساعد في تعزيز مناخات الثقة الداخلية، والخارجية كذلك.
غيّر إسقاط النظام السوري في 8 ديسمبر (2024)، كل المعادلات الإقليمية، وأنهى محوراً كان يبتزّ دول المنطقة. التغيير السوري فرصة ثمينة لتقارب عربي واسع، وعربي وتركي، وهو كذلك فرصة لعقد اتفاقيات السلام مع الدولة الصهيونية، شريطة الخروج من سورية، واستعادة الجولان، ولبنان، وتشكيل الدولة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة في العام 1967. استغلّت الدولة الصهيونية سقوط النظام لتدمير البنية العسكرية السورية، والتقدّم نحو المحافظات الغربية لسورية، حتى مشارف العاصمة. إن هذا التغيير الذي تضرّر منه المحور الإيراني، ولا تنظر إليه الدولة الصهيونية بعين الارتياح، يتطلّب من المستفيدين منه دعماً واسعاً، ولا سيّما أن أزمات سورية معقّدة للغاية، في كل المجالات، وقوة سورية هي قوة للمستفيدين كذلك.
اتفاق كلّ من السعودية وقطر (بصفة خاصّة) على دعم النظام الانتقالي مؤشّر إيجابي في تشكيل العلاقات الإقليمية من أجل رفع العقوبات ودعم الاستثمار في سورية وإعادة الإعمار، وهذا يتطلّب خطّةً وطنيةً من الإدارة السورية الجديدة، بما ينهض بمؤسّسات الدولة ودعم الشفافية فيها، وتعزيز استقلال القضاء والإعلام، وأن تتحدّد بدقّة المجالات الاقتصادية للاستثمار فيها، والتراجع عن تهميش دور الدولة الاقتصادي، وأن تضع السلطة، وبالتشاور مع كبار رجال الأعمال والخبراء والشخصيات الوطنية، تلك الخطّة بما يحدّد بدقّة موارد البلاد، وقدرات القطاع الخاصّ الوطنية، وحاجات البلاد الكبيرة للاستثمارات، ووضع القوانين الناظمة لهذه القضايا، وللاستثمارات الخارجية، وتحديد مجالاتها الاقتصادية.
زيارة الشرع تركيا واجبة، كما هي زيارة كلّ دولة عربية تبدي الرغبة في فتح علاقات ندّية ومتكافئة. تركيا دولة جارة، والحدود معها أكثر من 900 كيلومتر، ولعبت دوراً كبيراً في مساندة لشعب السوري في محنته منذ 2011. ولكن، وبعد تغيير النظام لا بدّ من علاقات تنطلق من سياسة خارجية تخدم المصالح السورية، وترفض أيّ تدخّلات في السياسة الداخلية. إن التوقيع على اتفاقية دفاع مشترك، أو التوافق حول قواعد عسكرية في سورية، كما تنشر بعض التقارير الصحافية، يجب ألا ينطلق من الموقف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو أيّ فصائل داخلية أو أيّ مشكلات داخلية في سورية. التشاور على أرضية الندّية هو الأصل، وأمّا المصالح المشتركة فتتأسّس، وفقاً للاعتبارات الداخلية، وبما يعزّز علاقات سورية مع دول المنطقة والعالم كافّة، ونستثني منها في الوقت الراهن كلّاً من إيران والدولة الصهيونية، نظراً إلى دور إيران في دعم النظام السابق ضدّ مصالح الشعب السوري، واحتلال إسرائيل مناطق واسعة غربي سورية.
تحقيق مصالح الشعب هو الأساس في إرساء العلاقات الخارجية، وهو الأساس في تشكيل النظام السياسي والدولة الجديدة، وضمن ذلك، لا بدّ من تشكيل حكومة وطنية ونشر الإعلان الدستوري المؤقّت، مدخلاً للمرحلة الانتقالية، وبما ينظّم شؤون السوريين، ويعزّز الأمن والخدمات العامّة، ولا بدّ من التحضير الدقيق للمؤتمر الوطني العام، وعدم إقامة أيّ اتفاقات عسكرية في هذه المرحلة، مع تركيا وسواها. يمكن عقد هذه الاتفاقيات حينما تحصل سورية على نظام دستوري، وشرعي، ويتحقّق هذا بعد إجراء الانتخابات العامّة، وانتخاب كلٍّ من المجلس النيابي ورئيس الجمهورية وحكومته، أي في نهاية المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
العربي الجديد
———————————-
سورية… خطوة في مشوار الألف ميل/ حسان الأسود
06 فبراير 2025
تضافرت عشرات الأسباب في سقوط نظام القمع الدموي في سورية في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024؛ وقوفه ضدّ الإرادة الشعبية الذي يعني وقوفه ضدّ طبيعة الأشياء وقوانين المجتمع؛ قيامه على اعتبار مصالح فردٍ واحدٍ وحلقة ضيّقة من المنتفعين قلّص قاعدته الاستنادية؛ همجيّته في قتل الثائرين عليه واعتقالهم وتهجيرهم، التي دمّرت الدولة باقتصادها وبناها الخدمية وأسس وجودها؛ اعتماده على العسكر والأمن، الذي قتل المجتمع وهدّم أصل الحياة في أيّ دولة؛ اعتماده على قوىً خارجيةٍ، وأخرى طائفيةٍ غير منضبطة، أفقده الدور الوظيفي الذي من خلاله كان قد بنى شرعيّته في الإقليم؛ انحيازه لمحور إيران الذي أفقده التوازن المطلوب للاستمرار على ساقِ القبول الدولي، بعد أن كسر ساقه الداخلية بيديه؛ استنفاده (بغباء منقطع النظير) الفرصة تلو الأخرى، فتحت من خلالها الدولُ أبوابَها أمامه، من دون أيّ محاولة منه لتغيير ذاته المعطوبة.
ما كان لجهةٍ أن تضبط الحالة السورية أكثر من فصيل هيئة تحرير الشام، فالعقائدية والانضباط والجهوزية التي تمتّع بها جعلته الأكثر تأهيلاً للحلول في محلّ نظامٍ منخور حتى نقيّ عظامه. التجربة الإدارية في منطقة ضيّقة (ومحدودة) فتحت له هامشَ الإدارة بحدودها الدنيا، وبأدنى الدرجات البدائية المطلوبة. المرونة السياسية لقيادته، والتواصلات العميقة مع الدول، من خلال أجهزتها، ورسائل التطمين الواضحة، خلّفت الانطباع بإمكانية وجود البديل القابل للحياة. المقبولية العامّة عند فئات عريضة ووازنة من السوريين والسوريات، وضعف الأجسام السياسية والمدنية الموجودة في الساحة، والتعب العامّ من سنوات الحرب، ولامركزية قرار الفصائل العسكرية، ومحدودية تواصلها البيني، وقلّة فاعليتها الناجمة عن تفرقها وقلّة المقبولية الشعبية عند غالبيتها، أسباب مهمّة جداً، وباجتماعها ساهمت في هذه النتيجة.
تسلمّت الجماعة دولةً منهارةً بكلّ معنى الكلمة، ولأن ذلك كان ضمن ظروفٍ غير طبيعيةٍ من جهة التحدّيات الداخلية والخارجية، فقد استوجب من هذه الجماعة تدابير احترازية لتدعيم سيطرتها العسكرية بسيطرة أمنية وإدارية، فكانت الوزارة في المرحلة الأولى من لونٍ واحدٍ يتّصف بالولاء المطلق. اتسمت المرحلة الأولى من لحظة سقوط النظام البائد فعلياً، وحتى تاريخ إعلان هذا السقوط، بسماتٍ عديدة، أهمّها غياب التواصل المباشر مع القوى السياسية التقليدية، وتحييد الأجسام والكيانات الثورية والمدنية، وحصر التواصل مع الفئات الشعبية من خلال الإعلام البديل. اتُّبِعت سياسة الغموض وجسّ النبض وقياس ردّات الفعل، سواء عن معرفة مسبقة وتخطيط أم عن قلّة تجربة وتخبّط، من خلال إطلاق بوالين الاختبار حول قضايا جوهرية، مثل مؤتمر الحوار الوطني، إنهاء الحالة الفصائلية، التشاركية في بناء الدولة، وتطمين المكوّنات السورية المختلفة. حصرت الجماعة تركيزها داخلياً في الخطر الأكبر المتمثّل بالفصائل العسكرية، التي تملك القدرة على تثبيت الواقع أو قلبه في الوقت ذاته. خارجياً استكملت القيادة البراغماتية تثبيت علاقاتها الإقليمية والدولية، التي عملت عليها في المرحلة السابقة، على المستوى الأمني بالحدّ الأدنى. كانت الرسائل الأكثر حِنكةً وديناميكيةً تلك التي وجّهتها إلى دول الجوار والإقليم والدول الكُبرى: صفر مشكلات إقليمياً، وانخراط إيجابي بالأدوات السياسية، وعودة إلى الحضن العربي وقطع دابر التأثير الإيراني بالمطلق، وسدّ الذرائع أمام إسرائيل بعدم التطرّق للصراع معها إلا من باب القانون الدولي والمؤسّسات الدولية، وعدم إهمال مصالح الدول الكُبرى، وإيجاد توازن مقبول بينها.
أعلنت القوى العسكرية المجتمعة 29 الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني)، قرارات جاءت بمثابة إقرار الأمر الواقع: إعلان انتصار الثورة السورية، واعتبار 8 ديسمبر (2024) يوماً وطنياً. إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية. حلّ مجلس الشعب واللجان المنبثقة منه. حلّ جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية. حلّ جميع الأجهزة الأمنية العائدة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها وجميع المليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسّسة أمنية تحفظ أمن المواطنين. حلّ حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدّمية، وما يتبع لها من منظّمات ومؤسّسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية. حلّ جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسّسات الدولة. تولّي أحمد الشرع رئاسةَ البلاد في المرحلة الانتقالية، وقيامه بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، وتمثيلها في المحافل الدولية. تفويض رئيس الجمهورية تشكيل مجلس تشريعي مؤقّت للمرحلة الانتقالية، يتولّى مهامه إلى حين إقرار دستورٍ دائمٍ للبلاد، ودخوله حيّز التنفيذ.
تأتي هذه القرارات تحصيل حاصل من الناحية الفعلية، فالشرع استقرّ منذ وصوله إلى دمشق في قصر الشعب، وتبوّأ سدّة الرئاسة، وتصرّف بوصفه قائداً ورئيساً. الدستور الذي أُعلِن تعليقه كان معلّقاً فعلاً منذ إقراره، فلم يطبّق النظام البائد منه حرفاً. أمّا القوانين الاستثنائية فلم يُعمَل بها حقيقةً منذ يوم سقوط النظام. حزب البعث وأحزاب الجبهة ومنظّماتها توقّفت عملياً عن العمل، بل أصدر “البعث” قراراً بذلك، وتخلّى عن جميع الممتلكات والأصول، التي كانت تحت سيطرة الدولة. كذلك، انحلّ الجيش، واندثرت المليشيات العسكرية، وفرط عقد الأجهزة الأمنية المرعبة فعلياً لحظة السقوط. يبقى القرار الوحيد الذي لم ينفّذ فعلياً، ويصعب الحكم حالياً على إمكانية تنفيذه، المتعلّق بحلّ جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسّسات الدولة، وهذه تحتاج إلى نقاش وتفصيل وتوسّع.
هل يشمل القرار قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وإن شملها، ما السبيل إلى تنفيذه فعلياً؟ هل تلجأ الرئاسة إلى الحرب أم تستكمل طريق السياسة والتفاوض؟ هل يشمل القرار أيضاً الجيش الوطني، وهل تنفّذه فصائل هذا الجيش من دون اعتراض أو مقاومة؟ هل يشمل هذا القرار الحكومةَ المؤقّتةَ في الشمال والائتلاف وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية؟ وهل يملك المؤتمرون السوريون حلّ كيانٍ مؤسّس بقرار دولي كاللجنة الدستورية، وبتفويضٍ دولي، كائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التفاوض؟ هل يشمل القرار جميع المؤسّسات الثورية والسياسية، كالأحزاب والتحالفات والمجالس والهيئات ومنظّمات المجتمع المدني غير المسجّلة في سورية، وما هو السند القانوني لإلغائها، ما دامت مسجّلة في بلدان أخرى أو غير مسجّلة أو مرخّصة في سورية على الأقل؟
الإجابة على هذه الأسئلة، وغيرها كثير، رهن بالواقع الداخلي بتعقيداته كلّها، وبالتوافقات والتفاهمات الإقليمية والدولية، وبفاعلية الكيانات التي تمسّها هذه القرارات، وبالقبول الشعبي وما يُبنَى عليه من دعمٍ أو إعاقة. يجب ألا ننسى هنا قوى النظام المهزومة، التي لن تتوقّف عن محاولات الإعاقة والتخريب، ويجب ألا ننسى القوى الإقليمية التي تتبنّاها وتدعمها كإسرائيل وإيران وغيرهما.
ليس موقف مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) وقواتها العسكرية (قسد) ضعيفاً، لكنّه ليس قويّاً أيضاً. هو مرتهنٌ، بشكل أو بآخر، بالتفاهمات الأميركية التركية. لا يتوقّع أن تسلّم إدارة ترامب ورقة التحكّم الكبيرة هذه للأتراك أو للرئيس الجديد بسهولة، هناك استراتيجية أميركية في المنطقة تجعل الوجود الأميركي في شمالي سورية وشرقيها أمراً ضرورياً. لن يتمكّن الأتراك من إزالة الوجود الكردي من سورية، فهم أساساً ينهجون مسار السياسة التصالحية معهم في تركيا نفسها، أمّا الأكراد السوريون فهم كالعرب السوريين منقسمون شيعاً وفرقاً أيضاً، لكنّ التغيرات الكبيرة التي جرت مع سقوط النظام ستدفعهم إلى الحوار البيني من كلّ بدّ، وإن لم يفعلوا سيكونون الخاسر الأكبر في معادلة شدّ الحبال هذه. ليست القيادة السورية في عجلةٍ من أمرها، إلا بأن تحصل على الموارد الكُبرى الواقعة تحت سيطرة “قسد”، فإعلان النصر رفع أسهمها شعبياً، وهو عامل ضغط إضافي على “مسد” و”قسد”. يمكن للقيادة السورية الجديدة انتظار نتائج التوافقات التركية الأميركية، لكن عليها أيضاً أن تقدّم حلولاً عملية وواقعية تتضمّن بعض أوجه المشاركة، وتضمن بعض الحقوق الكردية المشروعة ضمن الإطار الوطني السوري.
ما هو موقف فصائل الجيش الوطني من هذه القرارات؟ كيف ستدخل ضمن تشكيلة الجيش السوري الجديد؟ وهل يمكن تفكيكها وتوزيع أفرادها وفصلهم عن قياداتهم؟ وهل تقبل بذلك إن بقيت “قسد” كتلةً واحدةً، وهل تقبل هي و”قسد” الانحلال إذا لم تحلّ قوات هيئة تحرير الشام نفسها؟ ثمّ كيف يمكن حلّ قوات هيئة تحرير الشام العسكرية، وهي التي حلّت محلّ الجيش السوري والأمن، وهي التي دخلت كتلةً واحدةً في البنية الجديدة لوزارة الدفاع؟ أليس في طلب القيادة السورية الجديدة من الفصائل حلّ نفسها تناقضٌ مع ما تقوم به هي ذاتها من ناحية أنها تركّز السلطات العسكرية كلّها في يدها؟ ما هو الضامن لدى قادةٍ كثيرين في أن يحافظوا على مكتسباتهم أو أن يتجنّبوا التهميش بالحدّ الأدنى والملاحقة أو التصفية بالحدّ الأعلى من الممكنات؟… هذه ليست أسئلةً افتراضيةً، بل هي واقعٌ مطروقٌ لا بدّ من إيجاد الحلول له بكلّ جديّة وحكمة، وإلا لن نصل إلى الهدف المنشود.
يُفهَم من الكلام المتعلّق بحلّ الأجسام الثورية السياسية والمدنية، الائتلاف واللجنة الدستورية وهيئة التفاوض والحكومة المؤقتة، ودمجها في مؤسّسات الدولة مباشرةً، وجميع هذه الأجسام تقع في مناطق النفوذ التركي المباشر. لكن كيف ستُدمج هذه المؤسّسات ضمن هيكلية مؤسّسات الدولة، وما الحاجة إليها، خاصّة وزارات الحكومة المؤقتة والمجالس المحلّية وبقية الهياكل التنظيمية المدنية مثل النقابات والاتحادات وغيرها؟ ليست هذه القضايا مُجرَّد أسئلة مشروعة، إنها مجموعة متشابكة من الإجراءات الاقتصادية والإدارية التي تترتّب عليها مسائل حياتية يومية لمئات آلاف الأسر السورية في تلك المناطق. أمّا بالنسبة لكلّ من الائتلاف وهيئة التفاوض، فإنّ مبرّر وجودهما انعدم مع سقوط النظام، ولا مشكلة تثيرها مسألة إعلان وفاتهما، لأنهما كانا عالةً على الثورة السورية، ولم يحظيا بأدنى مستويات القبول الشعبي. بالنسبة للجنة الدستورية، يمكن القول ببساطة إنها الكيان الوحيد الذي يحتاج حلّه إلى شرعية دولية باعتباره أنشئ استناداً للقرارات الأممية، ويمكن الاستفادة من بعض عناصرها ومنجزاتها على قلّة المفيد منها. مع ذلك، لن يشكّل تجاهلها أيّ معضلة كُبرى، لا عند الشعب السوري، ولا عند قيادته الجديدة، ولا حتى عند الدول التي ستتخفّف من عناء الإنفاق عليه مع إدراكها بأنّها كانت طوال الوقت تنفخ في قربة مقطوعة.
المشكلة التي تحتاج حلّاً حقيقياً شمول المؤسّسات الثورية والسياسية كالأحزاب والتحالفات والمجالس والهيئات ومنظّمات المجتمع المدني في قرارات الحلّ المذكورة أعلاه. فمن هذه المؤسّسات النقابات الحرّة التي أثبتت فاعليتها خلال أعوام الثورة، بل إنّ بعضها تسلّم تركة النقابات المركزية السورية بعد التحرير. ثم قد لا تلتزم الكيانات السياسية من أحزاب وتحالفاتٍ ومنظّمات مجتمع مدني مسجّلة خارج سورية بهذه القرارات، فمن سيمنعها من العمل في بلاد المهجر مثلاً، أو كيف ستطاولها قوانين الدولة السورية، إن لم تسجّل في قيودها؟… قد تتمكّن الإدارة السورية الجديدة من تنظيم عمل هذه الهيئات والمؤسّسات بعد صدور الإعلان الدستوري المؤقّت أو التشريعات المؤقّتة المرتقبة من المجلس التشريعي الانتقالي، فبموجب قانون الأحزاب وقانون النقابات وقانون المنظمّات والجمعيات، يمكن ضبط عمل هذه الكيانات العاملة في فضاء المجتمع المدني، وبغير ذلك يتعذّر تنفيذ مضمون هذه القرارات. والحقيقة أنّ الدولة السورية الجديدة بحاجة إلى توسيع فضاء المجتمع المدني وإلى ضبطه وتنظيمه، لأنها لا يمكن أن تستغني عنه، ولا أن تتجاوزه، ولا أن تغطّي الجوانب المهمة التي يغطّيها نشاطه.
العربي الجديد
——————————
هل تنجو الحرية الفكرية من المعتقلات والرقابة الشعبوية؟/ سميرة المسالمة
6 فبراير 2025
تشكل حرية الفكر ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والنهضة في المجتمعات، إذ تُعد المحرك الرئيسي لإبداع البشر وتطوير المجتمعات. ومنذ زمن بعيد أصبح الفكر الحر عاملًا مؤثرًا في صياغة الأفراد والمجتمعات، وصوغ هوياتهم، وأنماط حياتهم، وتشكيل مستقبلهم، علمًا أن معطى الحرية فردي، إذ لا يمكن الحديث عن حرية جماعية، او حرية شعب، بدون حرية الفرد، المواطن.
الحرية إذًا تتيح للأفراد التعبير عن ذاتهم، وإرادتهم، وآرائهم، وتبادل الأفكار دون قيود. مع ذلك، فإن مسألة الحرية في مجتمعاتنا العربية تواجه تحديات جسيمة تنبع من ضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأفراد على التعبير بحرية والمشاركة في صنع القرار. ومحور المسألة هنا هو افتقاد تلك المجتمعات إلى فكرة المواطن، الحر، المستقل، المتساوي مع غيره، أي افتقاده إلى المكانة القانونية والسياسية، في دول تسلطية لا تعترف بحقوق المواطنة اصلا.
في سورية، على سبيل المثال، بالرغم من غياب قيود صريحة على الحريات الفكرية، حتى الآن، حيث السلطة لا تزال في طور التشكل وصياغة الإعلان الدستوري والمجلس التشريعي والحكومة التنفيذية، وحيث أن آليات الرقابة “الحكومية الأمنية” التي يعرفها المجتمع السوري “معطلة”، ظهرت آليات رقابة تطوعية (أون لاين) على الفكر وحرية الرأي، يمكن تسميتها “تشبيحية” تمارس حالة قمع فكري وتشويه ثقافي، وتضع الكتاب والمفكرين أمام ثنائية “إما مع السلطة أو الصمت”. مع التنويه أن هذه المحاولات “الشعبوية” وضعت نفسها في خدمة السلطة بدون تكليف منها، وهي تمارس ذات الأعمال التي مارسها النظام السوري المخلوع ضد المعارضين لحكمه الأمني من خلال جيشه الإلكتروني.
لهذا يمكن القول إن السعي المبكر لتجاوز عقبات حماية حرية التعبير مسألة ملحة، بحكم المخاوف المشروعة من استمرار الظروف السياسية الراهنة، والتي تشهد نقصًا في الضمانات القانونية التي تتيح للمثقفين التعبير عن آرائهم بحرية، في الوقت الذي نرى فيه الغوغائيين يتمكنون من فرض تصنيفاتهم على الكتابات، ليصبح ما يسمى شعبيًا مصطلح “التطبيل” للسلطة هو معيار الوطنية لاحقًا، وبخاصة أن ما يثير تساؤلات عن هذه الأمور تحديدًا، هو التهجم على الفكر والرأي الحر – من قبل صفحات غير معروف ارتباطها بالسلطة- وهو ما يواكب الصورة النمطية عن توجهات الجماعات الإسلامية التي تولت السلطة في بلاد متفرقة من العالم، على الرغم من أن الرئيس السوري أحمد الشرع خرج من عباءة الانتماءات الضيقة، وأكد ضرورة الانتقال من عقل الفصائلية إلى عقل الدولة، أي ليس بالضرورة هيمنة أيديولوجيات الفصائل التي أسهمت بتحرير سورية على القرار السوري الوطني.
لهذا فإن غياب الرؤية الواضحة من قبل الجهات الرسمية يترك المثقف السوري في موقف صعب، حيث يُحتمل أن تتسبب الأزمات السياسية في خلق مناخ من الترقب والقلق الذي يؤثر سلبًا على الإنتاج الفكري والثقافي والفني.
“ظهرت آليات رقابة تطوعية (أون لاين) على الفكر وحرية الرأي، يمكن تسميتها “تشبيحية” تمارس حالة قمع فكري وتشويه ثقافي، وتضع الكتاب والمفكرين أمام ثنائية “إما مع السلطة أو الصمت””
ولعله من المفيد التذكير بأن التحديات الثقافية كبيرة في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي الذي يشهده البلد، إذ يؤدي ضعف الدعم الحكومي ومخاوف القطاع الخاص وتدني مستويات التمويل المخصص للمشاريع الثقافية إلى تقويض فرص العمل الحر والإبداع المبتكر. وفي هذا السياق، لا يقتصر الأمر على قلة الموارد المالية فحسب، بل يمتد إلى ضعف البنية التحتية للمشهد الثقافي والإعلامي الذي ينبغي أن يكون منبرًا للتعبير الفكري.
وعليه فإن المثقفين يواجهون تحديات مضاعفة من أجل إيجاد بدائل تمكنهم من نقل تجاربهم وأفكارهم إلى الجمهور، وهو ما جعل من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بديلًا ملحًا للخروج من إطار القيود التقليدية؛ إلا أن هذه صارت متاحة أيضًا لشن هجمات منظمة ضد نوع معين من المثقفين المبدعين والنقديين لجعلهم ينزوون، في مقابل رواج نوع من مثقفين “شعبويين”، لا يضيفون شيئًا، سوى التمسح بالسلطات السائدة، بغضّ النظر عن نوعها.
إن تحديد وجهة الحكومة في الاستفادة من تجارب آخرين في هذا المجال تنعكس إيجابًا على الحياة الثقافية والفنية في سورية، حيث أن الاستفادة من تجارب دول أخرى تمنح السلطة إمكانية التغلب على هذه القيود بطرق مبتكرة. فقد اتخذت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، خطوات تدريجية نحو فتح آفاق جديدة للتعبير الثقافي من خلال خطة “رؤية السعودية 2030″، حيث سعت الحكومة إلى تخفيف القيود الاجتماعية والثقافية بصورة منهجية بدون المساس بالتراث القيمي الراسخ، على رغم أن هذا التحول أثار جدلًا واسعًا داخل المجتمع، إذ دعا النقاد إلى ضرورة الموازنة بين الإصلاحات الفكرية والمبادئ التقليدية التي يحافظ عليها المجتمع، إلا أنهم مع كل هذا، قفزوا خطوات واسعة نحو الانفتاح الكامل على كل الثقافات والأنشطة الفكرية والفنية.
صحيح أن تحقيق حرية الفكر لا يقتصر على التغلب على القيود السياسية أو الاقتصادية فحسب، لأنه في المقابل يتطلب أيضًا دعمًا مجتمعيًا شاملًا يشارك فيه المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمبادرات الثقافية المستقلة، إذ إن هذا الدعم المتبادل هو حجر الأساس لبناء مناخ فكري يشجع على الإبداع والابتكار، ويسهم في خلق فضاء يُمكن الأفراد من استثمار إمكانياتهم الفكرية بأقصى قدر ممكن. ومن هنا، تبرز أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات كخطوة استراتيجية نحو تحقيق نمو فكري وثقافي يعكس واقع التحديات ويسعى نحو تجاوزها، ويفشل مخططات الأيديولوجيات المغلقة في كم أفواه المثقفين والمفكرين والكتاب والإعلام.
وفي نهاية المطاف، يبقى الأمل معقودًا على قدرة المثقفين والفنانين على ابتكار أساليب جديدة للتعبير وتحقيق التغيير في ظل الظروف الصعبة، إذ إن استثمار الإمكانيات التكنولوجية كما حدث في دولة قطر، وتعزيز الدعم المشترك من المجتمع المدني يُعد السبيل الأمثل لتجاوز العقبات وإطلاق العنان للإبداع. وعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، فإن المستقبل يحمل في طياته إمكانية تحقيق نمو فكري وثقافي يعكس قدرة الأفراد على تجاوز الأزمات وتحقيق التقدم. وفي هذا الإطار، يصبح تعزيز حرية الفكر ليس مجرد هدف سياسي أو اجتماعي، بل ضرورة ملحة تشكل الأساس لبناء مجتمع متحضر يستطيع مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وإيجابية، ويضمن النقد البناء لمجتمع ينهض من تحت الركام الذي خلفه نظام استبدادي قمعي اعتقل في سجون فساده سورية الدولة والشعب لنحو أربع وخمسين سنة.
*كاتبة سورية.
ضفة ثالثة
———————————–
لبنان وسوريا: من سيغار من الآخر؟/ يوسف بزي
الخميس 2025/02/06
العاصفة التي اقتلعت الأسدية من سوريا، تختلف عن العاصفة التي ضربت لبنان. هناك كان السوريون يحررون بلدهم بإرادتهم وعزيمتهم، بعد عذابات وتضحيات مهولة. وهنا كان اللبنانيون -رغماً عنهم- يتلقون مصائب حرب إسرائيلية عدوانية، حطّمت منظومة حزب الله العسكرية والمدنية، فتلاشى جبروته المعنوي وتسلطه السياسي والأمني.
السوريون، وبسرعة خاطفة، وجدوا أنفسهم في خضم قيادة وسلطة مؤقتة أو انتقالية، منسجمة ومتكافلة، تصدر يومياً وأحياناً بالساعات قرارات متلاحقة، تحسم فيها الكثير من المعضلات المتراكمة كجبال من التحديات والمصاعب والطموحات المؤجلة.
اللبنانيون، ورغم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتكليف رئيس وزراء جديد، كلاهما ترجمة سياسية لانكسار شوكة حزب الله، إلا أنهم يعجزون حتى اليوم عن ترميم النظام السياسي المتهالك، وعن إنتاج سلطة جديدة تطوي صفحة منظومة الكارثة والإفلاس.
خلال شهرين، ثمة تحولات سورية خاطفة للأنفاس. ليس فقط هذا التنفس العارم للحريات، وللحيوية السياسية التي تنبض في الشوارع والمنتديات وصفحات التواصل والإعلام، إنما أيضاً هذه الإنجازات الديبلوماسية والخطوات الكبرى في جمع الأصدقاء وتأمين مظلة عربية- دولية، ومصادر دعم. وهذا معطوفاً على حكومة فعّالة ومنضبطة، تعمل تقريباً بلا نوم، في مجال تحسين الخدمات والأمن، وتتخذ قرارات في الإصلاح الاقتصادي والقانوني والإداري.. كورشة هائلة لن تنتهي لسنوات مديدة.
وهنا في لبنان، لا تزال كل القضايا عالقة ما بين الوعود والخيبة، ما بين المناورات والكمائن والخداع. “الانتظار” سيد الموقف. كأن الحرب لم تنته بعد، والموالاة لم تنهزم بعد والمعارضة لم تعرف كيف تنتصر بعد، والنظام القديم يأبى المغادرة، والسلطة الجديدة تتأجل ولادتها مع مخاطر فعلية بتشوهات تعتريها.
في سوريا، نتلمس بداية لنظام مالي-مصرفي، خطط واستثمارات وتمويلات وتشريعات. مبادئ سياسية تتوضح وتتبلور، نحو دستور جديد. رؤية تنموية وطنية تتمظهر في مسودة الاتفاقات الكبيرة التي تُكتب الآن مع تركيا والسعودية وقطر والاتحاد الأوروبي.. أبواب سوريا مفتوحة لأحلام عظيمة، رغم أن المخاوف والكوابيس لم تتبدد كلياً.
في لبنان، خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الوراء. “العصابة” أقوى من الدولة. اللبنانيون يجمعون الرغبة بالتغيير والتمترس بحزبياتهم الطائفية في آن معاً. يجمعون توقهم للتخلص من الفساد، وتمسكهم بشبكة المصالح الفاسدة، في تناقض رهيب لا ينفكون عنه. امتناع بنيوي عن مقتضيات الدستور وحرص محموم على المحاصصة. التعطيل والتعطيل المضاد أصل السياسة ومرجعها.
في سوريا، مسيرة بناء الهوية الوطنية الجامعة تنطلق منذ شهرين، بالتوازي مع ظاهرة شاملة للتبرؤ من الأسدية، وإلحاح على مطلب العدالة الانتقالية. وها هي تجذب الآن شبابها وشاباتها الذي اكتسبوا الثقافات المتنوعة والخبرات والعلم في بلاد اللجوء والاغتراب، بما يسهم في نهضة ابلاد.
في لبنان، الهوية الوطنية لا تزال في خانة السؤال والالتباسات والخيانات المتبادلة. والعدالة موقوفة عمداً. وما زال طارداً لشبابه وشاباته، ولأصحاب المهارات والقدرات والمبادرات الخلاقة.
وجهة سوريا، ومنذ ليلة سقوط النظام الإجرامي، تبدو واضحة: الانفتاح على العالم، مصالحة الدول العربية، تطبيع العلاقات مع الغرب، الحياد الإيجابي، السيادة والاستقلال، أولوية الازدهار الاقتصادي وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، الانفكاك التام عن محور الممانعة.
وجهة لبنان، شبهة الوصاية الدولية، الانقسام العميق، ازدواجية السلاح وقرار الحرب والسلم، عجز عن تطبيق القرارات الدولية، خراب اقتصادي وتباطؤ متعمّد بل تمنّع مقصود عن الإصلاحات.
سوريا التي كانت متأخرة في كل المجالات ومدمرة، سياسياً وبيئياً واقتصادياً واجتماعياً.. تبدو اليوم كقطار سريع يعبر نحو المستقبل، وربما سيجتاز المحطات الصعبة بوقت أبكر بكثير مما نتوقع. ونأمل ذلك. ونأمل أن تستمر سوريا في صنع المعجزات.
لبنان في إيقاع مختلف، متعثر ومتباطئ وكسول. وقد يجد نفسه خلال السنوات القليلة المقبلة، متخلفاً ومفوتاً الفرصة التاريخية السانحة الآن. ولا نستغرب أن نرى حينها لبنان، بلداً غير جذاب، مهملاً ومنبوذاً وبيروت مطفأة، فيما تتحول سوريا إلى ماليزيا جديدة، ودمشق عاصمة تتوهج.
سوريا ولبنان لطالما كانا بمسار واحد (سيء إجمالاً وقسري أغلب الأحيان). اليوم، هناك “خطر” أن ينفصل مسارهما، على نحو يصبح فيه لبنان لأول مرة ربما يحسد سوريا ويغار منها.
المدن
——————————–
ثقافة “فاست فود اللوائح” السورية/ علي سفر
الخميس 2025/02/06
يطلب مني أصدقاء سوريون وعرب ترشيحات لأسماء شخصيات فاعلة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، وأحاول دائماً التملص من إجابتهم عن طلباتهم! يعود هذا لإدراكي أن أي اختيار أقوم به، ستقابله اختيارات مختلفة يقدمها آخرون، لا تتضمن الأسماء ذاتها، وهذا سيجعل رأيي عرضة للشك، حتى وإن كنت أحوز ثقة من يطلب أو يسأل!
دائماً، هناك من يقرر بأن هذا الشخص هو أفضل من ذاك، وإذا خرجنا من الدوائر الضيقة، وذهبنا نحو شبكات التواصل الاجتماعي، فإن السؤال عن التفضيلات، وكذلك الإجابات ومرجعياتها تذهب بالمراقب الخارجي، أي الغريب عن البلد ومشاكله، نحو قراءة الحالة على أنها فوضى، حيث لا يمكن إصلاح ما تسببه من تقليل قيمة أي شخصية فاعلة في مجالها، ودفع بدائل أخرى، لا تمتلك المقومات الأساسية، نحو الواجهة!
ينشر أحد الصحافيين في فايسبوك، طالباً من متابعي حسابه أن يذكروا أسماء “الإعلاميين الثوريين”، فتنسدل لائحة غرائبية من التعليقات، تجتمع فيها ترشيحات من كل حدب وصوب! وربما لو قام الصحافي، بتصويب السؤال، عبر تحديد زاوية الرؤية، لقلّت النتائج. ويمكن لمثال عن هذا أن يشرح العملية المطلوبة. فلو سأل عن المواطنين الصحافيين، أو الناشطين الإعلاميين وفق التسمية الرائجة، فإن عدد الإجابات سيتضاءل، وإذا حدد منطقة أو مدينة أو محافظة هؤلاء، فإن هذا سيسهم في جعل الأسماء أقل. لكنه لو فعل هذا، أو اتبع هذا النهج، فإنه سيخسر التفاعل الواسع، من الجمهور الذي يسعد بالمشاركة، طالما أن هذا لا يكلفه شيئاً، سوى تذكر من يعرفهم، أو من يروقون له، فيهرع لتدوين أسمائهم، ويجتهد أحياناً في منحهم الألقاب التعظيمية.
ضمن هذا المسار، يتحول التواصل الاجتماعي إلى حالة عبث انشطارية، لا تنتهي، وبدلاً من أن يتم البحث في المنجزات والمؤهلات، يصبح الهاجس هو عدد المعجبين، ممن يعتبرون أن مجرد قيامهم بالانضمام للائحة الخاصة بمن يسأل، يمنحهم حق الاختيار.
يتواطأ الشخص الذي يطرح هذه الأسئلة مع جمهوره. فهو يقدم لهم السؤال العام الفضفاض، ليحصل على أكبر نسبة من المشاركات، بينما يحاول الأفراد من الجموع الحاضرة لديه، عبر الإجابات، وضع أنفسهم في الخريطة، أو لنقل حيازة بعض الأهمية.
وعلى مسافة قريبة، يطرح أحدهم سؤالاً عمن ترشحه جموعه من السوريين لحضور المؤتمر الوطني السوري العتيد، فتدب بينهم الحمية الإقليمية والدينية والطائفية، لنصرة هذا الاسم أو ذاك، ويصبح الأمر أشبه بسوق مزدحمة لا تُسمع فيها أصوات “الوشيشة”(*) المتعالية.
ورغم أن صاحب السؤال يدرك أن الدعوات لحضور مثل هكذا مؤتمر، لا ترتبط باختيارات المشاركين في هذه “الحفلة”، لكنه يستمرئ الأمر، ولا ينتبه – وربما يتجاهل- إلى أن صناعة بروباغندا لشخصيات محددة، وبالاعتماد على الآراء الاستنسابية، ليس مفيداً في هذه المرحلة، بل إنه قد يضر، لجهة أن الفائزين الذين يمنحهم جمهور السوشال ميديا الميداليات والكؤوس، قد يكونون خارج السباق في الحياة الواقعية، لأن عوامل الاختيار ستكون مبنية على معايير مختلفة، كالتمثيل السياسي، أو القومي، أو الديني، أو الطائفي، حيث يؤدي هذا التناقض إلى إثارة الشكوك بين أوساط العامة في آليات الاختيار.
كما أن مطالبة البعض بأن يحضروا هم أنفسهم في الفعالية الوطنية، قد تحتاج إلى قيامهم بجمع توكيلات في مناطقهم، أو في المجال الذي يعملون فيه. وهذا النظام اعتُمد في سوريا العام 1919، حين تنادت الفعاليات العامة من أجل حضور المؤتمر السوري العام، الذي نتجت عنه الدولة الوطنية الأولى (المملكة السورية)، والتي قامت فرنسا المنتدبة بتدميرها لاحقاً.
وأطرف ما مر في سياق استعراض نقد الظاهرة، قيام أحد الأشخاص بطرح سؤال عن ترشيحات للعقلاء في المشهد السوري! ومكمن المفارقة هنا، أنك لا تستطيع أن تطلب لائحة بالعقلاء، عبر سؤال لا يقوم على منطق عقلاني. ولو كلف السائل نفسه، وبحث عن معنى المصطلح وتضاعيفه، لاكتشف بأن المحددات أوسع بكثير من أن يضمنها في منشوره الارتجالي. لكن الهوس بالمشاركات والإعجابات يطغى، حيث تصل الأمور إلى ذروة اللاعقلانية، فيدوّن مُعلق أو تسجل مُعلّقة اسميهما في اللائحة، ولا ضير! طالما أن أحداً لا يدقق أو يسأل عما يحدث هنا، في هذه الحالة أو تلك.
يقترح تطبيق “تشات جي بي تي” على الدارسين، تسمية هذه الممارسة الشائعة بـ”عصف الأسماء” أو “حملة الترشيح الجماهيري” في حال قررت مؤسسة ما استفتاء جمهورها، عن شخص غير محدد، ليصل إلى هدف ما. لكن الوجاهة والمنطق يفرضان على الجمهور، ألا يورد أسماء من خارج المجال المحدّد المطلوب، وإذا حدث أن رُشّح اسم من فضاء مختلف، سيكون الحدث ساخراً وغير جدّي!
وفي المقابل يطرح التطبيق تسميات عديدة، للممارسة الفوضوية التي نتحدث عنها الآن، ومنها: “لعبة الترشيحات” أو “تسلية الأسماء” و”ترشيحات المزاج” وأيضاً “لائحة بلا عنوان” وكذلك “حفلة الترشيح العشوائي”. لكنه في نهاية المطاف يُفضل أن نسميها “مطاردة الأسماء”، حيث يكون التركيز على التفاعل في حد ذاته، وليس على الغاية النهائية.
لكن ما لا يدركه التطبيق، أن الموضوع في الحالة السورية مهم، وليس طرفة. فما سأقترح تسميته بـ”فاست فود اللوائح” يغدو الآن كارثة محلية، بعدما بات يحوز اهتمام أصحاب القرار ممن يلتفتون إلى أدوار وأسماء “المؤثرين” في السوشال ميديا، قبل أن يفتحوا صحيفة أو مجلة أو كتاباً ليعرفوا كيف تبدو سوريا ومن خلفها العالم، خارج فايسبوك وغيره من الشبكات.
(*) تعبير مستخدم في سوريا عن أولئك الذين يسوّقون البضائع عبر المناداة عليها بصوت عالٍ، حيث يؤدي تجاور عدد من هؤلاء في المكان ذاته إلى إحداث ضجيج هائل. وقد تم استخدام التعبير، في الإشارة إلى من يقومون بتسويق رحلات البولمانات وباصات “الهوب هوب” في كراجات المدن الكبرى.
المدن
—————————————–
سوريا نحو آفاق التعافي: إدارة التحديات في المرحلة الانتقالية/ محمود الحسين
الخميس 2025/02/06
بلغت سوريا شهرها الثالث منذُ سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، في حدثٍ مفصلي يُعَدُّ من أبرز محطات تاريخ سوريا الحديث منذ تأسيسها في المؤتمر السوري العام عام 1920. غير أن التحديات الجسام التي تواجه الحكومة الانتقالية تتمثل في إرثٍ ثقيل من أعباء حكم عائلة الأسد الذي امتد لأكثر من خمسة عقود. يمكن تصنيف هذه التحديات إلى محورين رئيسيين: الأول، تحدي تحقيق الأمن والاستقرار في ظل أوضاع شديدة التعقيد. والثاني، التحدي الاقتصادي الذي يتطلب معالجة تراكمات عقودٍ من الفساد وسوء الإدارة.
التحديات الأمنية واستحقاقات الاستقرار
مع سقوط النظام السوري فجر الثامن من ديسمبر 2024، انهارت المؤسسة العسكرية والأمنية انهيارًا تامًا، ولاذ ضباط وعناصر الجيش والأمن بالفرار. في أعقاب ذلك، بادرت الحكومة الجديدة إلى افتتاح العديد من مراكز التسوية في مختلف المحافظات السورية، وعلى الرغم من غياب الإحصائيات الدقيقة حول أعداد الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، إلا أن محافظة اللاذقية وحدها شهدت تسوية أوضاع نحو 40 ألف عسكري.
ورغم هذه الجهود، لا يزال الوضع الأمني في سوريا برمته يعاني من عدم الاستقرار. وتواجه الحكومة الانتقالية السورية تحدياً في آلية التعامل مع فلول النظام السوري، ويتمثل هذا التحدي في التعرض المستمر لعناصر إدارة الأمن العام لسلسلة من الكمائن والهجمات التي تستهدف حواجزها المنتشرة في مختلف المحافظات السورية. وتتنوع الدوافع الكامنة وراء هذه الهجمات، وأبرزها رفض مبدأ التسوية بشكل قاطع نتيجة التخوف من المحاسبة بسبب التورط في جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين. كما تسعى بعض هذه الأطراف إلى كسب الوقت على أمل حدوث تحولات تفضي إلى جر البلاد نحو صراع مذهبي، مما يتيح لها التمترس ضمن هذا السياق على أمل أن يكون ذلك موئلاً لهم للتهرب من العدالة. إضافةً إلى ذلك، تبرز الدوافع الاقتصادية؛ حيث تورط العديد من عناصر جيش النظام السوري والميليشيات المرتبطة به في بناء اقتصاد حرب موازٍ، قوامه الرئيسي تصنيع وتهريب “الكبتاجون”، واستغلال المدنيين وابتزازهم عند نقاط التفتيش العسكرية في السابق.
في سوريا، يشكل تحقيق الاستقرار تحديًا كبيرًا، ولا سيما في المجال الأمني. يُؤمَّل من الحكومة السورية الجديدة اليوم أن تُولي أهمية قصوى لفرض حالة من الأمن والاستقرار، باعتبارها مصلحة مشتركة للحكومة والشعب السوري ولدول المنطقة كافة. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين تبني مسارين رئيسيين لا غنى عنهما، المسار الأول: العدالة الانتقالية، التي تقتضي محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضمن إطار قضائي عادل، وهو ما يسهم في الحد من أي عمليات انتقام فردية قد تنشأ في حال تم العفو عن هؤلاء المجرمين؛ مما قد يأخذ البلاد إلى مُنزلق لا يريده السوريون ولا يحتمله مستقبل سوريا. المسار الثاني: إطلاق عملية شاملة -لعناصر النظام السابق لمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري- يُطلق عليها عملية نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج. يكون هدفها الأساسي تحويل المقاتلين السابقين إلى حياة مدنية، وهي تشمل ثلاث مراحل، الأولى تسليم الأسلحة من قبل المقاتلين، والثانية تفكيك الهياكل العسكرية غير النظامية، والثالثة مرحلة طوية من عملية إدماج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً في مجتمعاتهم. ولا بد من الحصول على دعم مالي وتقني من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة من أجل ضمان نجاح العملية.
واجهت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تحديات جمّة عند تطبيقها في بعض الدول العربية التي عصفت بها نزاعات مسلحة، مثل العراق وليبيا. ففي العراق، عقب الغزو الأمريكي عام 2003، جرت محاولات لتسريح المقاتلين السابقين، وصدر قرار بحل الجيش والأجهزة الأمنية. غير أن هذه الجهود افتقرت إلى خطة واضحة لإعادة دمج المقاتلين في المجتمع، ولم يكن هناك نهج شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد الطائفية والاقتصادية، بل على العكس، شابت هذه المحاولات سياسة الإقصاء التي استهدفت مجموعات بعينها بناءً على اعتبارات طائفية، ما أدى في نهاية المطاف إلى ظهور كيانات مسلحة متعددة، كان من أبرزها الحشد الشعبي وتنظيم الدولة الإسلامية. أما في ليبيا، فقد واجهت برامج نزع السلاح والدمج صعوبات عديدة بعد سقوط نظام القذافي عام 2011. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتسريح الميليشيات المسلحة، إلا أن هذه البرامج اصطدمت بتحديات رئيسية، تمثلت في تعدد الفصائل المسلحة، وغياب حكومة مركزية قوية، وصعوبة مراقبة انتشار السلاح.
التحديات الاقتصادية
في سوريا اليوم تتركز جهود الدول ولا سيما دول الخليج العربي على تلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية بصورة أساسية. ولذلك بادرت هذه الدول إلى إطلاق جسور برية وجوية لإيصال المساعدات إلى الأراضي السورية. كان للحرب والاستبداد والعقوبات آثاراً كارثية على المدنيين. مع نهاية عام 2024، كان التمويل الإنساني قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 14 عامًا، حيث لم تتلقَّ خطة الاستجابة الإنسانية سوى ثلث التمويل المطلوب، بينما لم تُموَّل استجابة فصل الشتاء والاستعداد للفيضانات في شمال غرب سوريا سوى بنسبة 10% فقط. وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد وانتصار الثورة السورية، لا تزال الاحتياجات الإنسانية مهولة في جميع أنحاء البلاد. ففي شمال غرب سوريا، يحتاج نحو 4.2 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى المساعدة الإنسانية، نصفهم يعيشون في نحو 1500 مخيم في محافظتي إدلب وشمال حلب، ويواجهون ظروفًا قاسية تتفاقم مع الشتاء وندرة الخدمات الأساسية. ومع الحديث عن عودة المهجرين، خصوصاً من دول الجوار كتركيا ولبنان والأردن، حيث تُشير الإحصائيات إلى عودة نحو 200 ألف شخص منذُ سقوط النظام السوري. لتتزايد الضغوط على البنى التحتية والخدمات الأساسية الهشة أصلًا. لذا، يُعد دعم وتأهيل هذه القطاعات أمرًا جوهريًا لضمان عودة كريمة وآمنة للمهجرين وتحقيق تعافٍ مجتمعي مستدام يقطع الطريق أمام أي اضطرابات مستقبلية.
وتتجلى الأولوية القصوى اليوم للحكومة السورية الجديدة في العمل مع الدول الصديقة والوكالات الأممية والجاليات السورية في الشتات على تحقيق رفع تدريجي للعقوبات. ويُستفاد من الرخصة التي أصدرتها الولايات المتحدة مؤخرًا للسماح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية بهدف تسهيل تقديم الخدمات الأساسية. وكذلك اتفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي على تعليق تدريجي لمدة عام للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ضمن إطار “مقاربة التحرك خطوة خطوة”. هذه الإجراءات، إن استمرت، كفيلة بتعزيز الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.
المدن
———————————–
سورية أم سوريا؟ تاء مربوطة أنيقة يا عشّاق الألِف!/ فاروق مردم بك
الخميس 2025/02/06
اعتدت منذ الصغر على كتابة كلمة “سورية” بالتاء المربوطة. وعلى الرغم من اعتراض بعض الأصدقاء المتحمّسين للألف، لا أرى سبباً وجيهاً لمخالفة القاعدة التي اعتمدها الجغرافيّون العرب القدماء، ومنهم على سبيل المثال ياقوت الحموي في “معجم البلدان”. وكان هذا مذهب اللغويّين في تعريب الأسماء الأعجمية، ولذلك وردت كلمة سورية بالتاء المربوطة في المعاجم الكبرى مثل “القاموس المُحيط” للفيروزابادي و”تاج العروس” لمرتضي الزبيدي.
ومن المعروف ندرة استعمال الكلمة في اللغة العربيّة للدلالة على بلاد الشام حتّى عصر النهضة حين ظهرت بقوّة وكُتبت بالتاء المربوطة. ففي العام 1860 أصدر بطرس البستاني، أوّل الداعين إلى وطنيّةٍ سوريّة جامعة، صحيفةً سمّاها “نفير سورية”، وتبعه صحافيّون وكتّابٌ آخرون، أشهرهم المطران يوسف الدبس في كتابه الضخم “تاريخ سورية الدنيوي والديني” الذي طُبع جزؤه الأوّل في بيروت في 1893 واكتملت طباعته في 1903. وكان قانون الولايات العثماني قد أنشأ في 1864 ولايةً باسم ولاية سورية، تضمّ سناجق دمشق وحماة وحوران والكرك، وكان عنوان النشرة الإداريّة السنويّة عن أحوالها، منذ 1865، “سالنامة ولاية سورية”.
وهكذا، بالتاء المربوطة أيضاً، كُتب الاسم في العهد الفيصلي (فأوّل جريدةٍ صدرت آنذاك في دمشق كان اسمها “سورية الجديدة”، أسّسها حبيب كحّالة في 1918)، ثمّ في أيّام الانتداب الفرنسي (مثلاً في دستور 1928 كما عُمل به معدّلاً بعد 1930، وكذلك في طوابع البريد)، ثمّ بعد الاستقلال، خصوصاً في المادّة الأولى من دستور 1950 الذي أقرّته جمعيّةٌ تأسيسيّة منتخبة انتخاباً ديموقراطيّاً.
لماذا لا تُحبّونها، هذه التاء المربوطة الأنيقة، يا عشّاق الألف؟!ّ
(*) مدونة نشرها الكاتب والناشر السوري فاروق مردم بك في صفحته الفايسبوكية
—————————————
بعد سقوط بشار الأسد… هل تتغيّر خارطة الهجرة العالميّة؟/ عائد عميرة
06.02.2025
لسنوات عدة، بقيت أزمة سوريا واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، لكن مع سقوط نظام بشار الأسد، من المنتظر أن يعود مئات الآلاف من السوريين إلى بلادهم للعيش بين أهلهم وتعويض سنوات الشتات التي عاشوها، ومع ذلك فإن مسألة العودة ليست سهلة ولا ترتبط بسقوط الأسد فقط.
في آذار/ مارس 2011، انتفض الشعب السوري ضد حكم الطاغية بشار الأسد، الذي واجه المتظاهرين بالحديد والنار، إذ استخدم الأسلحة الكيماوية والبراميل. ومع تسلّح الثورة، استقدم الروس والإيرانيين ومرتزقة آخرين، لتوطيد أركان حكمه المتزعزع، وقتل أكبر عدد من السوريين.
قُتل عدد كبير من السوريين؛ قدّرتهم الأمم المتحدة بما بين 580,000 و617,910 أشخاص، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، فيما اضطر أكثر من نصف السكان إلى مغادرة مناطق عيشهم، أي نحو 13 مليون شخص، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
نصف هؤلاء اضطروا للنزوح داخل البلاد لأسباب عدة، فيما توجّه النصف الآخر وعددهم قرابة الـ6 ملايين شخص، إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن ومصر، في حين اختار آخرون الهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا.
لكن مع سقوط الدكتاتور منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، برزت أسئلة عدة متعلقة بوضع اللاجئين والمهاجرين السوريين، بخاصة حول إمكانية عودتهم إلى بلادهم، وكيفية تعامل الدول المستقبِلة مع الوضع الجديد.
المهاجرون واللاجئون السوريون في أرقام
لجأ نحو 6 ملايين سوري إلى أي بلد يمكن الوصول إليه، الغالبية العظمى اختارت ويمكن أن نقول إنها اضطرت للعيش في دول مجاورة في المنطقة، مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وتستضيف تركيا وحدها أكبر عدد من اللاجئين السوريين، قُدّر بنحو 3,7 مليون سنة 2021، وبتاريخ الأول من آب/ أغسطس 2024 بلغ عددهم 3,1 مليون، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويستضيف لبنان 814 ألف لاجئ سوري، أما الأردن فيوجد فيه 660 ألف لاجئ، و257 ألفاً في العراق، و145 ألفاً في مصر، وبضعة آلاف في تونس وليبيا والجزائر والمغرب، وفق إحصاءات صادرة سنة 2022، عن المنصة العالمية المتخصصة في البيانات والأعمال “ستاتيستا“.
وبلغ عدد السوريين الذين يعيشون في ألمانيا نهاية سنة 2023 نحو 973 ألفاً، من بينهم ما يقارب الـ 712 ألف شخص يبحث عن الحماية، وفق بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، وهم بذلك يشكلون واحدة من أكبر الجاليات المهاجرة في هذا البلد.
كما يتوزّع عشرات الآلاف من السوريين على دول أوروبية أخرى، وقد لجأ السوريون أيضاً إلى الولايات المتحدة، وفيها تمّت إعادة توطين حوالى 21 ألفاً، وبقي نحو 8 آلاف يُقيمون على أساس برنامج الحماية المؤقتة، الذي يمنح مهاجرين يواجهون حروباً أو كوراث في بلادهم، حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة لمدة محددة، أي أن وجودهم مؤقت.
بدورها، أعادت حكومة كندا توطين أكثر من 44 ألف لاجئ سوري، بين خريف سنة 2015 و31 كانون الثاني/ ديسمبر 2016، كجزء من مبادرة إعادة توطين اللاجئين السوريين التي تهدف إلى حمايتهم من بطش نظام المخلوع بشار الأسد.
طرق الهجرة
بالنظر إلى هذه الأرقام، تُعتبر سوريا من أبرز البلدان المصدّرة للاجئين في العالم، تليها أفغانستان بـ 2,6 مليون لاجئ، ثم جنوب السودان وميانمار والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورندي، وتجدر الملاحظة أن هذه الأرقام لا تتضمن النازحين داخلياً.
اعتمد السوريون طرقاً وأساليب عدة للهجرة، تتغير وتختلف حسب الشخص والمنطقة التي يتّجه إليها، لكن الجامع بينها، صعوبتها ومخاطرها الكثيرة، إذ يخاطر السوريون بحياتهم للنجاة من ظلم بشار وزبائنيته.
الوصول إلى تركيا ولبنان كان يسيراً بعض الشيء بالنسبة إلى السوريين، نظراً الى قرب المسافة الجغرافية، لكن الوصول إلى باقي الدول؛ ومنها العربية، كان أمراً عسيراً ويتطلب مجازفة كبرى، حتى إن الآلاف ماتوا في تلك المغامرات.
هدف غالبية اللاجئين كان الوصول إلى البر الأوروبي، هرباً من نظام بشار في المقام الأول، وثانياً حتى يتمتعوا بحياة أفضل، فالبقاء في تركيا أو لبنان وباقي الدول العربية يعني معاناة إضافية ومتاعب أكثر، توازي ما كانوا يعيشونه تحت ظل نظام البعث.
اختار السوريون طريقي البحر والبر للوصول إلى أوروبا، ويُعتبر طريق البحر المتوسط الأكثر شعبية للمهاجرين، بخاصة في جزئه الشرقي، إذ شهد المسار بين تركيا واليونان عبور مئات الآلاف من السوريين منذ سنة 2012، وهذا لا ينفي أن السوريين استخدموا المسار الغربي أيضاً، وذلك انطلاقاً من دول المغرب العربي.
فضلاً عن هذا المسار، اعتمد عدد مهم من السوريين طريق غرب البلقان، الذي يمتد عبر مقدونيا وصربيا، وصولاً إلى كرواتيا وسلوفينيا والمجر للوصول إلى أوروبا، ويستقر الواصلون في غالبيتهم، عبر هذا الطريق في ألمانيا والنمسا.
وفي ظل المضايقات الكثيرة التي مُورست ضد السوريين في هذا الطريق، اختار عدد منهم طريقاً موازياً من ألبانيا عبر الجبل الأسود أو صربيا إلى البوسنة والهرسك، وآخرون اختاروا سلْك الطريق المار عبر بلغاريا ورومانيا.
فضلاً عن هذه الطرق، اختار آلاف من اللاجئين السوريين الوصول إلى أوروبا من طريق بيلاروس، مروراً بليتوانيا وبولندا أو عبر روسيا إلى فنلندا، وتنامى استعمال هذا الطريق في ظل الأزمة الأوروبية البلاروسية.
الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، يمكن اعتباره بمثابة “رحلة موت”، إلا أنها رحلة فُرض على السوريين القيام بها للنجاة بحياتهم من بطش نظام البعث الدكتاتوري. وبعد سقوط بشار مباشرة، أعلن عدد من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا والسويد وبلجيكا واليونان والدنمارك والنرويج، تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، فيما أعربت النمسا عن عزمها إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم قريباً.
نتيجة هذه الإجراءات، سيُحرم أكثر من 100 ألف سوري من اللجوء القانوني في دول الاتحاد الأوروبي، وهو عدد مطالب الحماية الدولية المقدّمة من السوريين، التي لا تزال قيد الدراسة في الدول الأعضاء. ويُذكر أن 128 ألفاً و500 سوري حصلوا على نوع من الحماية الدولية بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر 2024.
حتى الدول العربية التي تحتضن اللاجئين السوريين، أو تلك التي تمثّل ممرات عبور نحو أوروبا على غرار تونس وليبيا، من المرتقب أن تشدد إجراءاتها بعد سقوط نظام بشار الأسد. ويُشكل اللاجئون السوريون نحو ربع عدد اللاجئين المسجلين في تونس، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
في الأثناء، بدأ آلاف اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم تدريجياً فور سقوط المخلوع، وأظهرت الصور والفيديوهات اكتظاظاً على المعابر بين سوريا ولبنان وبين سوريا وتركيا، مع توفير المزيد من الخطوات المبسطة، والإجراءات التي تتزايد تسهيلاً يوماً بعد آخر.
سوريا “بلد آمن”؟
استقبل الأوروبيون في سنوات الثورة السورية الأولى مئات الآلاف من السوريين، وكان هدف غالبية الحكومات الحصول على يد عاملة شابة ومتخصصة في ظل ارتفاع نسبة المسنين في هذه الدول، لكن في السنوات الأخيرة تغير الحال وتنامت موجات التضييق ضد المهاجرين، بخاصة مع صعود اليمين المتطرف.
فرض الأوروبيون قوانين وإجراءات صارمة لوقف الهجرة، ويرغبون حالياً في استغلال سقوط نظام بشار الأسد لمنع هجرة السوريين، وإعادة عدد من اللاجئين إلى وطنهم الأم، وقد عاينّا سرعة الإجراءات في هذا الصدد.
إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ليست أمراً يسيراً بالنسبة إلى عدد من الحكومات الغربية، بخاصة وأن عدداً مهماً من السوريين اندمج في اقتصاد تلك الدول، كما أن إعادتهم تتطلب تصنيف سوريا “بلداً آمناً”.
وتعرّف وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي الدولة الآمنة، بأنها الدولة التي “يُطبّق فيها القانون ديمقراطياً، ولا تؤدي الظروف السياسية فيها عموماً وبشكل ثابت، إلى الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللا نسانية أو المهينة، أو التهديد بسبب العنف العشوائي”.
وفقاً لهذا التعريف، من الصعب حالياً أن تصنّف سوريا كبلد آمن، نظراً الى الغموض الكبير الذي يحيط بالعملية السياسية في البلاد، وسير الأوضاع هناك. وإذا أصرت الحكومات على منح سوريا هذا التصنيف، فإنها ستواجه مشاكل قانونية كثيرة، فالوضع السوري ما زال ضبابياً وغير مستقر.
عودة طوعية؟
من المؤكّد أن مئات الآلاف من السوريين يتوقون إلى العودة إلى بلدهم والاستقرار هناك مجدداً، لكن من المبكر أن نشاهد عمليات عودة طوعية كبيرة، فالأوضاع كما قلنا في البداية غامضة ولا شيء واضح في المستقبل القريب.
صحيح أن اللاجئين في غالبيتهم فروا من هول ديكتاتورية بشار الأسد، لكن هروبهم يعود أيضاً الى سوء الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، وهذا الأمر لن يتم حلّه بسهولة، بخاصة وأن البلاد منهكة بالعقوبات والصعوبات الهيكلية، ما يعني أن عودة المهاجرين في الوقت الحالي لن تكون سهلة.
حتى من قرر العودة إلى سوريا، فإنه ينتظر ويترقّب ما سيؤول إليه الوضع في الفترة المقبلة، وتتركز غالبية مخاوف السوريين على استقرار الوضع الأمني والسياسي، والوصول إلى الخدمات الأساسية (صحة وتعليم وغذاء).
خارطة جديدة للهجرة
تشديد الإجراءات تجاه اللاجئين السوريين سيدفع عدداً منهم للعودة إلى بلادههم، وسيسهل على الحكومات الأوروبية أيضاً إعادة السوريين إلى موطنهم الأم، ما يعني أننا سنكون أمام خارطة جديدة للهجرة، فلسنوات عدة كان عدد اللاجئين السوريين هو الأكبر على مستوى العالم.
سبق أن توقعت مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ريما جاموس إمسيس، عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلدهم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
من المتوقع أن تتصدر فنزويلا في الأشهر القليلة المقبلة قائمة الدول المصدرة للاجئين في العالم، وحالياً يوجد 6,2 مليون لاجئ فنزويلي تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.
فيما صدّرت كل من أوكرانيا وأفغانستان 6,1 مليون لاجئ لكل منهما، ويرجّح أن يرتفع العدد في الأشهر المقبلة، مع تواصل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتواصل سيطرة “طالبان” على الحكم في أفغانستان.
كما يُتوقع أن يرتفع عدد اللاجئين الفارين من السودان نتيجة تواصل الحرب بين الجيش وميليشيات “الدعم السريع”، فضلاً عن ارتفاع أعداد اللاجئين القادمين من جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال، لتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإنسانية في هذه الدول الثلاث.
لسنوات عدة، بقيت أزمة سوريا واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، لكن مع سقوط نظام بشار الأسد، من المنتظر أن يعود مئات الآلاف من السوريين إلى بلادهم للعيش بين أهلهم وتعويض سنوات الشتات التي عاشوها، ومع ذلك فإن مسألة العودة ليست سهلة ولا ترتبط بسقوط الأسد فقط.
درج
———————————————
انحراف البوصلة الثورية.. مخاطر وحلول في ضوء الحالة السورية/ زاهر السلامة
6/2/2025
سيطرت فصائل مسلحة مناهضة للنظام السوري، الثلاثاء، على 18 قرية وبلدة بريف محافظة حماة وسط البلاد، لتصبح على بعد 6 كيلومترات من مدينة حماة مركز المحافظة. ودخلت الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل مسلحة تقودها “هيئة تحرير الشام”، يومها السابع، لتمتد باتجاه مدينة حماة. ( Kinene Hindevi – وكالة الأناضول )
الكاتب: يجب الحذر من مقايضة الإنجازات الثورية والمفاوضة على المبادئ الثابتة مقابل المكاسب السياسية والاقتصادية المؤقتة (وكالة الأناضول)
لا يكاد أحد من أنصار الثورة أو أعدائها يجادل في أن النصر الخاطف والسريع الذي حققه الثوار في سوريا، والذي تكلل بسقوط النظام وانتصار الثورة، كان حدثاً تاريخياً فريداً، فاجأ القاصي والداني، بل حتى الثوار أنفسهم.
وأياً كان القائل “الانتصار الأكبر ليس في تحقيقه، بل في المحافظة عليه”، فإن الواقع والتاريخ يشهدان بصحة ذلك. ومن هنا كانت المخاطر التي تتربص بالثورة بعد انتصارها هي الموضوع الذي يجب على الجميع دراسته والنظر فيه.
مخاطر جلية وأخرى خفية
من الجلي أن التنازع الثوري، والاقتتال الداخلي والارتهان الخارجي، من أهم المخاطر الواضحة التي تهدد الثورة المنتصرة.. ولكن تكمن في المقابل مخاطر خفية هي الأهم والأخطر، وعلى رأسها انحراف البوصلة الثورية. فما هي صور انحراف البوصلة الثورية؟ وما أسبابها؟ وكيف يمكن تجنبها؟
انحراف البوصلة الثورية
بالرغم من أن مصطلح “البوصلة الثورية” لم يستخدم بشكل مباشر في أدبيات السياسة والثورة، فإن موضوع “حرف الثورة”، أو انحرافها عن مسارها، موضوع حظي باهتمام كبير من المفكرين والفلاسفة السياسيين، وتناولته نظريات كثيرة بالبحث والتفنيد، حيث حاولت تحليل الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الثورات عن أهدافها الأصلية، والنتائج، وتقديم معالم واضحة لفهم هذه الظاهرة. وفيما يلي أبرز هذه النظريات والمفاهيم فيما يخص الحالة السورية:
نظرية التبعية (Dependency Theory):
من أهم النظريات التي تحدثت عن انحراف البوصلة الثورية نظرية التبعية؛ وتشير إلى أن الثورات في الدول النامية غالبًا ما تصبح عرضة للتبعية الاقتصادية والسياسية للقوى الكبرى، ما يؤدي إلى انحرافها عن أهدافها الأصلية.
وإن كان ابن خلدون قد لمح إلى خطورة التبعية النفسية للقوي الغالب، فإن أندريه غوندر فرانك، عالم الاجتماع الأميركي من أصل ألماني، هو من أهم من صاغ نظرية التبعية، وحذر من تحول الثورات إلى أداة تخدم مصلحة القوى المهيمنة بدلًا من تحقيق استقلال حقيقي.
احتمال الحدوث في الحالة السورية متوسط بسبب الضغوط الكبيرة، والوضع الاقتصادي الهش.
نظرية الفجوة الثورية (Revolutionary Gap Theory):
والخطر هنا يكمن في تشكل فجوة بين تطلعات الجماهير وأفعال القيادة الثورية، ما يؤدي إلى تضارب المصالح بين القاعدة والقيادة.
احتمال الحدوث في الحالة السورية متوسط إلى عالٍ بسبب انشغال القيادة بمخاطبة الخارج على حساب الداخل، وضعف الوعي السياسي لدى عموم السوريين بصعوبة التحديات التي تواجه القيادة، ومطالبتهم بالحلول السريعة.
الاغتراب الأيديولوجي (Ideological Alienation):
يشير إلى خطر تخلي القيادة عن المبادئ الثورية الأصلية، ومحاولة التكيف مع ظروف جديدة أو مصالح خارجية، ما يؤدي إلى فقدان الدعم الشعبي.
احتمال الحدوث في الحالة السورية ضعيف، بسبب رسوخ العقيدة في التشكيلات الثورية في مختلف مستوياتها.
إعادة إنتاج السلطة (Reproduction of the ruling power):
يرى ميشيل فوكو أن الثورات قد تنحرف، لأنها تعيد إنتاج أنماط السلطة التي قامت ضدها جزئيا أو كليا، كإعادة توظيف عناصر من السلطة السابقة، أو تقليد أساليبها في الحكم والإدارة.
احتمال الحدوث في الحالة السورية ضعيف إلى ضعيف جداً..
نظرية الفشل التنظيمي (Organizational Failure Theory):
من أهم روادها صامويل هنتنغتون في كتابه “Political Order in Changing Societies”؛ حيث أشار إلى أن الثورات تنحرف بسبب ضعف البنية التنظيمية التي تؤدي إلى تشتت الأهداف، ما يجعلها عرضة للاختراق أو الفوضى.
احتمال الحدوث في الحالة السورية ضعيف إلى متوسط، بسبب ضخامة التحديات وتعقيد الوضع السوري.
نظرية الثورة المضادة (Counter-Revolution):
تُركز على كيفية تدخل القوى الداخلية أو الخارجية لإجهاض الثورة أو حرفها عن مسارها لخدمة أهداف معادية.
احتمال الحدوث في الحالة السورية متوسط؛ فبالرغم من استئصال الدولة العميقة، فإن القوى الخارجية المتربصة بالثورة أكثر من القوى المساندة لها.
الحلول: كيف تتم المحافظة على البوصلة الثورية؟
الداخل السوري في المركز ثم يأتي الخارج بعد ذلك، لأن التجربة السورية أثبتت أن الداخل هو الحاضنة الثورية، ورأس المال السياسي لنجاح الدولة السورية، وأن الخارج -بأغلبيته لا كليته- كان ولا يزال بالعموم عدواً للثورة والتغيير، وعائقاً أمام نجاح تجربة الدولة الإنسانية.
الحذر من مقايضة الإنجازات الثورية والمفاوضة على المبادئ الثابتة مقابل المكاسب السياسية والاقتصادية المؤقتة.
الشفافية والوضوح مع الحاضنة الشعبية، وعدم إغفالها أو تهميشها.
الاستثمار الأقصى في الخبرات والعقول الوطنية التي أثبتت نزاهتها ومساندتها للثورة، واستقطاب أكبر كم ممكن منها لتشكيل هيئات استشارية، تضمن صواب القرار والتخطيط.
الاستئصال الجذري للدولة العميقة وروافدها، وإقصاء كل من كان جزءاً من الدولة العميقة من المشاركة في القرار أو التخطيط.
التقارب مع الدول على أساس المواقف ثم المصالح، وجعل المصالح المشتركة مع الدول النظيفة في مركز الاهتمام.
السعي الحثيث إلى بناء الدولة التي يسودها القانون والعدالة والمواطنة، وتخلو من كل أشكال الإقصاء والاضطهاد للإنسان.
استمرار الحاضنة الشعبية في دعم القيادة ونصحها، وتقديم كل إمكانياتها لعملية البناء والتطوير.
التنظيم على أدق المستويات من أهم عوامل الوقاية الثورية، للانتقال إلى دولة القانون والمحافظة عليها.
ختاماً
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى انحراف البوصلة الثورية، ويبقى أن التحدي الأكبر للثورات هو الحفاظ على التوازن بين المبادئ الأصلية والظروف الواقعية، مع تجنب الوقوع في فخ التبعية والتنازع والتحريف الأيديولوجي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
الجزيرة
———————————
الدستور السوري الجديد: التحديات والعواقب/ إيمره نديم أوغلو
6/2/2025
عملية صياغة الدستور السوري الجديد سيكون أمامها تحديات كبيرة بعضها متعلق بالنسيج الاجتماعي المعقد للمجتمع السوري وبعضها بسبب الفكر المهترئ للنظام البائد (الجزيرة)
تمثل صياغة دستور جديد لسوريا نقطة تحول تاريخية لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا ما بعد الأسد.
ومع ذلك، فإن إعداد هذا الدستور في ظل الظروف الراهنة يواجه تحديات معقدة، ترتبط بالانقسامات السياسية المتعلقة بتصفية الحسابات مع فلول النظام البائد، والتدخلات الخارجية، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن السوري.
ولأن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يحدد هوية الدولة، وينظم علاقتها مع مواطنيها، فإن أي دستور جديد يجب أن يتضمن رؤية شاملة لمعالجة آثار الحرب، ويمهد الطريق نحو العدالة والمصالحة الوطنية، مع ضمان حقوق الإنسان وإدارة موارد الدولة الطبيعية بشكل عادل.
ومما لا شك فيه أن عملية صياغة الدستور السوري الجديد سيكون أمامها تحديات كبيرة، بعضها متعلق بالنسيج الاجتماعي المعقد للمجتمع السوري، وبعضها بسبب الفكر المهترئ للنظام البائد، والذي عشش في مؤسسات الدولة طيلة فترة حكمه.
ومع تعقيدات الواقع السوري الحالي، تتداخل التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل عملية صياغة دستور جديد اختبارًا حقيقيًّا لإرادة الشعب في التغيير والإصلاح. وبين طموحات الشعب ومخاوف الواقع، سيجعل الدستور الجديد سوريا أمام مفترق طرق.
التحديات السياسية والاجتماعية في صياغة الدستور
الانقسام السياسي والاجتماعي:
تُعد الانقسامات السياسية والاجتماعية من أبرز التحديات التي تواجه صياغة الدستور السوري الجديد؛ فقد أفرزت سنوات الثورة أشباه تيارات سياسية، مثل الائتلاف الوطني، وبعض الأحزاب القومية كالمجلس الوطني الكردي والمجلس التركماني السوري، وتجمعات أخرى مختلفة اتفقت في توجهها لإسقاط النظام، لكنها اختلفت في التفاصيل والأهداف. هذه التيارات -رغم تنوعها- عززت فكرة الانقسام السياسي بعدم تمكنها حتى الآن من توحيد رؤيتها حول شكل الدولة المستقبلية.
التركيب المعقد للنسيج الاجتماعي في سوريا، والحقبة الزمنية الطويلة للثورة، التي قسمت الشعب بين ثائر قديم عاش كل تفاصيل الثورة وتضرر من التحاقه بها، وثائر ملتفّ ركب موجة الانتصارات، وبين ما بقي من فلول النظام. تجلى هذا الانقسام في الخلاف حول هوية الدولة؛ فبينما يدعو البعض إلى دولة علمانية تفصل الدين عن السياسة في دستورها، يرى الآخرون ضرورة إقامة دولة إسلامية، تستمد قوانينها وتشريعاتها من الدين الإسلامي الحنيف، ليعكس هذا الجدل اختلافًا عميقًا في التصورات الشعبية حول مفهوم الحكم والمرجعية القانونية، ما يجعل الوصول إلى وفاق وطني مهمة شاقة، تتطلب حوارًا حقيقيًا ومفتوحًا يضمن تمثيل جميع الأطياف والمكونات الاجتماعية.
التدخلات الخارجية
فرض تداخل مصالح القوى الدولية والإقليمية في سوريا ضغوطًا قد تؤثر على مسار صياغة الدستور الجديد؛ فمع وجود أطراف دولية تدعم تيارات سياسية متباينة، يصبح الوفاق الوطني أكثر تعقيدًا في ظل سعي بعض هذه القوى لفرض أجنداتها.
ويثير هذا الواقع مخاوف جدية بشأن فقدان استقلالية القرار السوري، ما يفرض على الدستور الجديد احتواءه على نصوص تحمي السيادة الوطنية، وتمنع أي تدخل خارجي في إدارة البلاد أو في صياغة مستقبلها السياسي.
وعليه، فإن ضمان استقلال الدستور السوري الجديد عن أي نفوذ خارجي هو خطوة أساسية لاستعادة ثقة الشعب بالدستور وبنفسه، من خلال ترسيخ مبدأ أن القرار السوري يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم؛ حيث عانى السوريون قبل الثورة وخلالها من انعدام الثقة في القيادات السياسية في الدولة وقدرتها على تحقيق إصلاح حقيقي. ولتعزيز هذه الثقة، يجب أن يتبنى الدستور آليات تضمن الشفافية والمساءلة، والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
المدة الزمنية لوضع الدستور:
في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن السوري يوميًّا، تشكل المدة الزمنية اللازمة لإعداد الدستور تحديًا كبيرًا؛ فبينما يتطلب إعداد دستور شامل ومستدام وقتًا كافيًا للتوافق على قضاياه المحورية، يعاني المواطنون من أزمات اقتصادية واجتماعية، سببتها سنوات الحرب العجاف.
هذا التناقض بين الحاجة إلى السرعة في التخفيف من معاناة الناس، وبين ضرورة التريث لضمان صياغة دستور متوازن وشامل، يضع واضعي الدستور أمام اختبار صعب. أي استعجال قد يؤدي إلى نصوص غير مدروسة تُفاقم الأزمات بدلًا من حلها، وأي تأخير قد يُعمق حالة اليأس الشعبي، ويؤثر على شرعية العملية برمتها. وبالتالي، يجب أن يتم وضع جدول زمني واضح ومتفق عليه، يراعي التحديات الحالية، دون الإخلال بجودة النصوص الدستورية.
القضايا الجوهرية التي يجب معالجتها في الدستور
حقوق الإنسان والحريات العامة:
يجب أن يكون ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة حجر الأساس في الدستور السوري الجديد؛ إذ فرض التنوع الاجتماعي في سوريا على صاغة الدستور الجديد أن يُكرَّس الدستور لحماية كرامة الفرد، وتعزيز المساواة بين جميع المواطنين، دون أي تمييز على أساس الدين أو القومية أو العرق أو الجنس، أو أي انتماء آخر.
يتطلب ذلك وضع نصوص دستورية صريحة تكفل حرية التعبير والاعتقاد، والتجمع السلمي، وحق المشاركة السياسية. كما يجب أن يتضمن الدستور ضمانات واضحة لحقوق الأقليات والفئات المهمشة، بشكل يُعزز التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمع السوري، وذلك بتوفير آليات فعّالة لحماية الحريات العامة من أي انتهاكات .
“إنشاء هيئات مستقلة تُعنى بمراقبة تنفيذ القوانين، وضمان تطبيقها بعدالة وشفافية، وبشكل يُرسّخ مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، كجزء أساسي من هوية الدولة المستقبلية”.
العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية:
تُعتبر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية السبيل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ومعالجة إرث الصراع الذي خلفته سنوات الثورة بين فئات المجتمع؛ فيجب أن ينص الدستور على آليات واضحة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، التي وقعت خلال الـ14 عامًا، مع ضمان العدالة للضحايا، دون اللجوء إلى تصفية الحسابات أو الانتقام.
تتمثل العدالة الانتقالية في كشف الحقائق، وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للمتضررين، ومحاسبة كل من تلوثت يداه بدماء السوريين، ليُفتح بذلك المجال أمام بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع. كما ينبغي أن يُكرّس الدستور دور المؤسسات المستقلة في إدارة هذه العملية بحيادية، لضمان تجاوز الانقسامات، وتعزيز الوحدة الوطنية.
“المصالحة الوطنية ليست مجرد خيار سياسي، بل هي ضرورة لبناء مجتمع سوري موحد. يتطلب تحقيقها تبني سياسات تحفز الحوار، وتُشرك جميع الأطراف في صياغة مستقبل مشترك، بما يضمن تجاوز الماضي الأليم، والبدء بصفحة جديدة قائمة على التسامح والاحترام المتبادل”.
إدارة الموارد الطبيعية والاقتصاد:
يجب أن يُكرّس الدستور السوري الجديد مبدأ أن الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمياه، هي ملكٌ للشعب، وتجب إدارتها بشفافية وعدالة لضمان استفادة جميع السوريين منها. ينبغي أن يتضمن الدستور نصوصًا تضع إطارًا قانونيًّا واضحًا لتنظيم استغلال هذه الموارد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
إلى جانب ذلك، يجب أن يركز الدستور على بناء اقتصاد متين ومستدام، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أمر بالغ الأهمية؛ حيث يمكن أن تكون هذه المشاريع المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وإعادة الإعمار. كما ينبغي أن ينص الدستور على آليات لتوجيه عائدات الموارد الطبيعية لتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية.
“إن الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية والاقتصادية ستكون واحدة من الأسس المحورية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار سوريا في المستقبل”.
ضمان الاستقلالية الاقتصادية:
ينبغي أن تركز النصوص الدستورية على دعم الإنتاج المحلي كركيزة أساسية للاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
يتطلب ذلك وضع سياسات تشجع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل؛ الزراعة والصناعة والطاقة، مع توجيه الموارد نحو تطوير مشاريع مستدامة، تسهم في تنويع الاقتصاد، وتقليل تعرضه للتقلبات الخارجية.
كما يجب أن يُلزم الدستور الدولة بتبني إستراتيجيات تدعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا الحديثة؛ لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية.
هذا النهج لن يسهم فقط في تعزيز النمو الاقتصادي، بل سيضمن أيضًا قدرة سوريا على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على بناء اقتصاد يحقق العدالة بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية.
التكنولوجيا ودورها في تعزيز الدستور الجديد
رقمنة الإدارة:
ينبغي أن يضع الدستور السوري الجديد أساسًا لتحول رقمي شامل في إدارة الدولة، بشكل يعزز كفاءة المؤسسات ويحارب الفساد؛ إذ تسهم الرقمنة في تسهيل الخدمات الحكومية، وتوفير البيانات بشكل فوري ودقيق، ما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة، ويقلل من الهدر في الموارد، كما يجب أن تُنشئ الدولة منصات رقمية تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، والرقابة على المشاريع والميزانيات العامة.
يمكن لهذه الأنظمة، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أن تقدم حلولًا مبتكرة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ومراقبة الإنفاق الحكومي. كما يتعين على الدستور أن يُلزم المؤسسات الحكومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملياتها، مع ضمان تدريب الكوادر الوطنية لتشغيل هذه الأنظمة بكفاءة.
“إن تبني الرقمنة لا يقتصر على تحسين الأداء الإداري، بل يعكس التزام الدولة بالشفافية والعدالة في إدارة شؤونها، ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها.”
دعم الابتكار والطاقة المتجددة:
يجب أن يركز الدستور السوري الجديد على تعزيز الابتكار لدفع عجلة التنمية المستدامة؛ مع وضع إستراتيجيات واضحة لتطوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
كما ينبغي أن تتضمن النصوص الدستورية التزام الدولة بتوفير حوافز للشركات الناشئة، والمشاريع التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحيوية.
كما يجب تخصيص موارد لدعم البحث العلمي، وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة محليًا، وتشجيع الشراكات بين القطاعين؛ العام والخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويُحسن كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
“من خلال دعم الابتكار واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، يمكن لسوريا أن تحقق قفزة نوعية نحو بناء اقتصاد مستدام وصديق للبيئة، يواكب التحديات العالمية، ويعزز استقلالها الاقتصادي.”
التعليم الرقمي والتدريب التقني:
يمثل التعليم الرقمي والتدريب المهني ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع السوري في مرحلة ما بعد الصراع.. يجب أن يركز الدستور الجديد على تعزيز التعليم التقني والمهني، مع دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية لضمان إعداد جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل الحديثة.
كما ينبغي توفير برامج تدريب مكثفة تُركز على مهارات استخدام الوسائل التقنية، وتطوير حلول تقنية مبتكرة. دعم هذه البرامج لن يسهم فقط في تأهيل الشباب، بل سيوفر لهم فرص عمل حقيقية تساهم في إعادة الإعمار ودفع عجلة الاقتصاد. إن جعل التعليم الرقمي والتدريب المهني أولوية وطنية يعزز من قدرات الأفراد، ويدعم التنمية المستدامة في البلاد.
العواقب المحتملة للدستور الجديد
سيناريو النجاح:
إذا نجح صاغة الدستور في تقديم نص حديث وشامل، يعكس تطلعات جميع فئات المجتمع، فإن ذلك سيمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. دستور مبني على أسس العدالة والمساواة سيخلق بيئة قانونية تضمن الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
نجاح هذا الدستور سيفتح الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية اللازمة لإعادة الإعمار، ما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتسريع عملية التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن دستورًا عادلًا، يرسخ قيم المصالحة الوطنية ويعزز الحريات الفردية، سيضع الأساس لبناء دولة قوية ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
سيناريو الفشل:
في حال فشلت عملية صياغة الدستور الجديد في التوصل إلى توافق وطني شامل، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية داخل البلاد. استمرار غياب رؤية موحدة حول شكل الدولة وطبيعتها سيُبقي سوريا في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ما يعيق أي جهود لإعادة الإعمار والتنمية.
إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تجاهل قضايا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى تصاعد التوترات الداخلية وزيادة الشعور بالظلم بين مختلف الأطياف.
وفي ظل استمرار التدخلات الخارجية وانعدام الإرادة السياسية المحلية، قد يتحول الفشل في صياغة دستور جامع إلى تهديد لوحدة البلاد، ما يُعزز احتمالات تفككها وتعميق أزماتها الإنسانية والسياسية. كما أن تجاهل العدالة الانتقالية قد يُشعل موجة جديدة من العنف والتوترات الداخلية، ما يُعيق أي جهود لإعادة البناء.
ختامًا: يُعد الدستور السوري الجديد خطوة بالغة الأهمية لرسم معالم سوريا المستقبل، لكنه ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو التزام ببناء دولة حديثة تُعزز العدالة والاستقرار.
ومع ذلك، فإن النجاح في صياغة وتنفيذ هذا الدستور يتطلب معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير آليات تُشجع المصالحة الوطنية بدلًا من تصفية الحسابات.
إن إشراك المواطنين في صياغة الدستور، واستخدام التكنولوجيا الحديثة كأداة للنهوض الاقتصادي، يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في مستقبل البلاد. وبذلك، يتحول الدستور إلى عقد اجتماعي حقيقي يُجسد تطلعات الشعب السوري نحو الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
مدون سياسي، باحث في هندسة الطاقة الكهربائية
الجزيرة
—————————————
العلاقة بين العرب والكرد في سوريا: تحديات وآمال/ خليل البطران
6/2/2025
رائج/ سوريا/ بمشاركة 1300 متطوع.. انطلاق حملة “رجعنا يا شام” لـ “إعادة الحياة إلى شوارع دمشق”
الكاتب: لا يمكن لأي حل أن يكون قائمًا على تسويات جزئية بل يجب أن يكون شاملًا يعيد صياغة مفهوم المواطنة على أسس جديدة (الصحافة السورية)
هل الصراع بين العرب والكرد في سوريا قدر محتوم؟ أم إنه نتيجة لسياسات تلاعبت بالمكونات السورية لخدمة أجندات خارجية؟
لطالما كانت العلاقة بين العرب والكرد في سوريا قائمة على التعايش المشترك؛ حيث جمعتهم روابط اجتماعية من جيرة ومصاهرة ومصالح اقتصادية، لكن العقود الأخيرة شهدت توترات سياسية غذّتها سياسات البعث سابقًا، ثم حزب العمال الكردستاني عبر ذراعه السوري “قسد”. ومع ذلك، ورغم اتساع الهوة، لا تزال هناك فرص حقيقية لإعادة بناء الثقة بين المكونين، استنادًا إلى الروابط التاريخية التي لم تنقطع.
قبل الثورة: تعايش رغم التمييز
قبل عام 2011، ورغم التمييز الذي مارسته السلطة بحق الأكراد، مثل قانون الإحصاء الذي جرّد بعضهم من الجنسية، لم يكن هناك صراع مباشر بين المكونين، بل شارك العرب والأكراد جنبًا إلى جنب في المظاهرات الأولى للثورة، في القامشلي والحسكة وغيرهما، مطالبين بالحرية والكرامة لكل السوريين.
لكن مع تصاعد النزاع، استغلت بعض الأطراف -سواء من النظام أو الفصائل المتشددة أو القوى الكردية المسيطرة- الانقسامات القومية لتعزيز نفوذها، ما أدى إلى تأجيج الصراعات الداخلية.
تنظيم الدولة واستغلال الورقة القومية
روجت بعض القوى السياسية الكردية لفكرة أن “العرب جميعهم دواعش”، وهي مقولة غير دقيقة، لأن تنظيم الدولة لم يكن تنظيمًا عربيًا، بل هو جماعة متطرفة عابرة للحدود، ارتكبت الفظائع بحق الجميع، عربًا وأكرادًا وإيزيديين وسريانًا.
لكن استغلال هذا الخطاب أدى إلى مزيد من الانقسامات، بدلًا من توحيد السوريين ضد الإرهاب بمختلف أشكاله.
“قسد” والهيمنة السياسية
مارست قوات سوريا الديمقراطية (قسد) دورًا في تعميق الفجوة؛ حيث تبنت خطابًا قوميًّا متشددًا، وفرضت واقعًا سياسيًّا لا يعكس التنوع الديمغرافي في المناطق التي تسيطر عليها، خاصة الحسكة ودير الزور. كما أن ارتباطها بحزب العمال الكردستاني التركي جعلها محل رفض من شريحة واسعة من السوريين، سواء العرب أو حتى الأكراد، الذين لا يؤيدون مشاريعها السياسية.
المسألة أوسع من العرب والأكراد
ليس الصراع في سوريا محصورًا بين العرب والأكراد، بل يشمل جميع المكونات السورية، مثل السريان، والآشوريين، والدروز والإيزيديين، الذين يعانون من تداعيات الحرب والانقسامات السياسية. لذلك، لا يمكن لأي حل أن يكون قائمًا على تسويات جزئية، بل يجب أن يكون شاملًا، يعيد صياغة مفهوم المواطنة على أسس جديدة.
رغم الخلافات: روابط التعايش لا تزال قائمة
ورغم هذه التحديات، فإن العلاقات الاجتماعية بين العرب والأكراد لم تنقطع. فما زالت هناك جيرة طيبة، وعلاقات قرابة، وتداخل اقتصادي بين المكونين. وهذا الإرث المشترك هو ما يمكن البناء عليه في المستقبل.
نحو حوار وطني شامل
لا يمكن تجاوز هذه الخلافات إلا عبر حوار وطني حقيقي، لا يقتصر على العرب والأكراد فقط، بل يشمل جميع مكونات الشعب السوري، ويرتكز على:
الاعتراف بحقوق جميع السوريين دون تمييز.
رفض المشاريع الانفصالية التي تهدد وحدة البلاد.
تعزيز مفهوم المواطنة بدلًا من التقسيمات القومية والطائفية.
سوريا تتسع للجميع
وفي الختام، إن مستقبل سوريا ليس للعرب وحدهم، ولا للأكراد فقط، بل هو لكل السوريين، بكل مكوناتهم، من عرب وكرد وآشوريين وسريان وكلدان، وجميع الطوائف والإثنيات الأخرى.
لا يمكن بناء مستقبل سوريا على أساس القومية الضيقة أو المحاصصة الطائفية، بل يجب أن يكون قائمًا على التعايش المشترك والمواطنة الحقيقية، حيث يحصل كل فرد على حقوقه دون تمييز، وتُبنى دولة عادلة تحترم تنوعها، وتوحد جميع أبنائها تحت راية الوطن.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وباحث في الشؤون السياسية والشؤون السورية
الجزيرة
————————————–
الجزيرة السورية على الطاولتين السياسية والعسكرية: الأهالي لا يريدون القتال، فماذا تُريد السلطات؟/ جلال الحمد
06-02-2025
في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 3 شباط (فبراير) 2025، صرّح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بأن المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية جارية، وأن العديد من التفاصيل لا تزال قيد النقاش، مؤكّداً أن قسد «عبَّرت عن استعدادها لأن تكون جزءاً من الجيش السوري». جاء التصريح بعد يومٍ من نشر تصريحات لقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عبّر فيها عن أن قسد «لا تريد التقسيم وأنها مستعدة لأن تكون جزءاً من مستقبل سوريا».
جاءت هذه التصريحات في ظل ظهور جهاتٍ متعدّدة تطالب الحكومة المؤقتة بفرض سيطرتها على مناطق سيطرة قسد بالقوّة العسكرية، تمثّلت بمظاهراتٍ في العاصمة دمشق ودعواتٍ واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تُسوِّق كل من الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية نفسيهما عبر سردياتٍ حجزت مساحةً لها في أذهان الآلاف وكوّنت دافعاً لتأييدهما، فالحكومة المؤقتة والفصائل المُشكّلة لها دخلت دمشق وحلّت محل بشار الأسد في مشهدٍ كان أقرب للمعجزة، فيما طردت قوات سوريا الديمقراطية تنظيم داعش من مناطق واسعة، بعد سنواتٍ من الرعب عاشها سكان دير الزور والرقة ومناطق في الحسكة وكوباني (عين العرب) ومناطق أُخرى.
الجزيرة السورية بعد سقوط النظام
ما أن بدأت قوات النظام السوري السابق بالانهيار في شمال البلاد ووسطها، وذلك بعد عملية ردع العدوان التي قادتها فصائل مسلّحة معارضة للنظام، حتى سَحَب النظام قواته وعتاده من مناطق عّدة، ومنها دير الزور، باتجاه جبهات القتال، إذ يبدو أنه أدرك حينها أن الدفاع عن وجوده يتطلّبُ حماية العاصمة أكثر من أيّ مكانٍ آخر. قبل سحب قواته من دير الزور، شنّت قوات سوريا الديمقراطية عمليةً عسكريةً محدودةً، استهدفت قوات النظام في القرى السبع الواقعة بالقرب من مناطق سيطرتها على الضفة الشرقية من نهر الفرات، ولكنّ العملية أخفقت، ليسلّم النظام هذه القرى بعدٍ أيام قليلة عبر انسحابه دون قتال. تتبّعت قسد القوات السورية المنسحبة خطوةً بخطوة، فيما بدا أنه تسليم النظام لمواقعه لقوات قسد التي سيطرت على مطار دير الزور، ثم دخلت مدينة دير الزور وعدداً من المناطق التابعة لمحافظة الرقة. حصل هذا التحرك بموافقةٍ كاملةٍ من التحالف الدولي الداعم لقسد والمشرف على تحركاتها، والذي خَشِيَ من الفراغ الأمني الذي ستخلّفه قوات النظام السوري، مما سيترك مناطق واسعة لتحرُّك تنظيم الدولة بحرية. وبالفعل، شن طيران التحالف في تلك الفترة غاراتٍ على مواقع يُعتقد أنها تابعة لتنظيم الدولة في دير الزور.
لم تنسحب قسد من مدينة دير الزور إلا بعد مفاوضاتٍ مع قوات هيئة تحرير الشام استمرت عدّة أيام، ولم تشهد تلك الفترة أيّ صدامٍ عسكري بين الطرفين، الأمر الذي أشار بوضوح إلى نجاح أول حوارٍ مباشرٍ بينهما بعد سقوط النظام، وهو ما تؤكّده الأوضاع الحالية في الجزيرة السورية وتصريحات القيادات السياسية والعسكرية.
بعد الاتفاق مع هيئة تحرير الشام، عادت قسد إلى مواقع سيطرتها السابقة، ولم تشهد المنطقة أي تحركاتٍ عسكريّةٍ تُذكر، إلا بعض الهجمات التي شنّها مسلّحون يُرجّح أنهم يتبعون لقوات العشائر التي شكّلها الشيخ إبراهيم الهفل، الأخ غير الشقيق للشيخ مصعب الهفل، شيخ مشايخ عشيرة العكيدات، والتي لم تؤدِّ إلى أي تغييرٍ في مناطق السيطرة.
مؤشّرات التحركات الشعبية
بعد دخول قوات سوريا الديمقراطية إلى مدينة دير الزور، اشتعلت مظاهراتٌ طالبت بخروجها وتسليم المدينة لقوات ردع العدوان والتأكيد على وحدة سوريا ورفض تقسيمها، وهو ما حصل بموجب مفاوضاتٍ كما ذكرنا آنفاً، والمُلاحظ خلال الأيام القليلة التي تواجدت فيها قسد في المدينة هو عدم وقوع مواجهات عسكرية مع الأهالي، رغم حالة الفوضى الأمنية التي خلّفها انسحاب قوات النظام السابق، وفوضى السلاح وعناصر مليشيات النظام الذين تواروا عن الأنظار بين الأهالي بالزي المدني. في الرقة، خرجت مظاهراتٌ حملت المطالب نفسها، وشهدت المحافظة بعدها لقاءاتٍ مكوكية بين القيادات المجتمعية وقيادات المجتمع المدني من جهة، وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية من جهةٍ أُخرى، بغرض تخفيف التوتر والإفراج عن المعتقلين على إثر المظاهرات. قُتل في مظاهرتي دير الزور والرقة عددٌ من المدنيين، ورغم ذلك لم تُسفر هذه الأحداث عن انفلاتٍ أمني وتحرّكٍ مُسلّح تجاه قوات سوريا الديمقراطية.
بعد عودة قسد إلى مناطق سيطرتها قبل 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، سلّم عشراتٌ من عناصرها في دير الزور سلاحهم وعادوا إلى منازلهم لسببين؛ الأول مادي، إذ قطعت قسد الرواتب الشهرية المخصصة لهم؛ والثاني لتجنّب خوض معركةٍ أظهرتها وسائل التواصل الاجتماعي قريبةً، خاصةً وأنها ستكون مع عناصر هيئة التحرير الشام الذين دخلوا دير الزور، والذين ينتمون في معظمهم لأهالي المحافظة.
لم تشهد المناطق الواقعة في الجزيرة السورية تحركاتٍ شعبية مسلّحة واسعة لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية، رغم استمرار الحشد الإعلامي والرغبة الواضحة لسكان دير الزور والرقة بتغيير واقعهم الحالي، إما بدخول قوات هيئة تحرير الشام أو بتغييرٍ جذري في إدارة مناطقهم إلى شكلٍ لا يشبه الإدارة الذاتية.
على عكس ما يروَّج إعلاميّاً، وبخلاف رغبات دعاة الحرب، توضح الأحداث خلال الشهرين السابقين أن السكان المحليين لا يرغبون بفتح حربٍ جديدة، فقد سئِموا الحروب كغيرهم من السوريين، كما ستضرر دير الزور والرقة بموجب أيّ حربٍ على الصعيد الاجتماعي، وأي قتالٍ بين الطرفين سيؤدي إلى جراح غائرة بين مكونات المنطقة، وسيتحمّل أبناؤها بعربهم وكردهم وزرها وتبعاتها لعقودٍ قادمة، خاصةً أن قياديين في الجيش الوطني متهمين بانتهاكاتٍ واسعة خلال عمليَّتَي نبع السلام وغصن الزيتون تسلّموا مناصب عسكرية في وزارة الدفاع السورية، وهذا ما سيؤجج أي معركةٍ عسكرية قد تحصل. وعليه فإن عدم حصول أي تحرك عسكري محلي كان واضحاً على أنه قرارٌ اتخذه أبناء محافظات الجزيرة السورية عن وعيٍ كاملٍ، رغم ظروفهم الاقتصادية والأمنية، ورغم كل الضغوط التي مورست وتُمارس عليهم.
تأثير تنصيب الشرع رئيساً مؤقتاً على مسار الأحداث شمال شرق سوريا
أثار تنصيب المجموعات العسكرية لأحمد الشرع رئيساً مؤقتاً لسوريا في 29 كانون الثاني (يناير) 2025، وقرار حلّ الفصائل وضمّها تحت مظلة وزارة الدفاع التابعة لحكومة تصريف الأعمال، سؤالاً رئيسيّاً حول مصير المعارك بين الجيش الوطني، المعارض والمدعوم من تركيا، وقسد، خاصةً في مناطق منبج وكوباني (عين العرب) وسد تشرين، فإنْ استمرت المعارك بعد حل الفصائل فلن تكون كسابقاتها، بل ستكون بين حكومة أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية، ما قد يستبدل الوصف من معارك بين فصيلين عسكريين إلى معارك بين وزارة الدفاع السورية وفصيلٍ متمرّدٍ عليها. جاء تصريح الشرع في 3 شباط (فبراير) مُطمئِناً بأن لا معارك قريبة، إلا أن التأثير التركي على سير المعارك منذ سقوط النظام قد يلعب الدور نفسه بالضغط على الشرع لاتخاذ خطواتٍ عسكرية في مواجهة قسد، وإن كانت محدودة، وذلك لتكريس الوصف الجديد لقوات سوريا الديمقراطية كجهة خارجة على القانون، حتّى قبل الحوار الوطني وتشكيل الحكومة المؤقتة والخطوات التي وعد بها الشرع في خطابه الثاني بعد التنصيب.
يضاف إلى العامل التركي المؤثر عاملٌ آخر، وهو القرار الأميركي في التعامل مع الوضع الجديد في سوريا، خاصةً وأن قوات سوريا الديمقراطية هي الحليف العسكري للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وجاء التغيير السوري في ظل انقلابٍ جيوسياسيٍّ كبيرٍ على مستوى الشرق الأوسط قادته إسرائيل بعد عملية السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وبالتالي فإنّ القرار الأميركي سيأخذ، بالضرورة، المصالح الإسرائيلية بعين الاعتبار في رسم ملامح سياسته تجاه سوريا الجديدة. وبهذا يمكن تفسير ما تداولته بعض الصحف عن نيّة الرئيس الأمريكي ترامب سحب قوّاته من سوريا، على أن أي تغيير في وضع القوّات الأميركية والتحالف الدولي بعد سقوط الأسد، لن يكون إلّا وفق صيغة تضمنُ أن تكون سوريا بلداً لا يصدّر العنف لبلدان الجوار، وتخرجُ بها من وضع الدولة الفاشلة التي تشكّل ثقباً أسوداً يجذب الأفكار والمجموعات المتطرفة، إلى بلد مستقر يعيش بحالة طبيعية مع كل جيرانه، وهذه الصيغة تتطلب بالضرورة وجود تيارات سياسية «مضمونة الجانب»، ليس فقط للولايات المتحدة وإسرائيل، بل لدول الإقليم وعلى رأسها دول الخليج العربي.
إذاً، يشكّل تنصيب الشرع رئيساً مؤقتاً عاملَ تعقيدٍ جديد لوضع الجزيرة السورية، فهو من جهةٍ يجعل من أيّ تحرّكٍ عسكريٍّ من قبل حكومة دمشق حرباً بين حكومةٍ وفصيلٍ متمرد، كما أجبر هذا الموقع الجديد للشرع قوات سوريا الديمقراطية على تقييم خياراتها من جديد، فهيئة تحرير الشام لم تعد الآن كما كانت قبل «مؤتمر النصر»، وسيُسلّط عليها الضوء أكثر وستكون مُرغمةً على حساب تحرّكاتها بدقة.
الشفافية والعقلية الجديدة ضرورتان
صار من الجلي أن الطرفين العسكريّين السوريين الأساسيين المعنيّين بالجزيرة السورية، أي حكومة الرئيس المؤقت وقوات سوريا الديمقراطية، لا يُفضّلان اللجوء للنزاع المسلح للاتفاق على مصير المحافظات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية، وهذا ما تعكسه تصريحات قيادَتيهما والوقائع في الميدان. ومن طرف المجتمع المحلي، فرغم حجم التحريض وانتشار السلاح والفراغ الأمني، لم يتم اللجوء إلى القوّة في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية حتى الآن.
رغم دعوتنا للحوار كطريقٍ وحيدٍ وإجباري لحسم الخلاف حول الجزيرة السورية، وعدم اللجوء إلى السلاح، فإنّ هذا لا يعني أبداً انتظار ما سيحصل بين الطرفين اللذين يتفاوضان دون أي تكليف، ويواجهان الكثير من الاعتراضات على أدائهما، وهنا لا بد من ممارسة كل أنواع الضغط من قبل المجتمعات المحلية والمنظمات المدنية، لترسيخ مطالب أهالي الجزيرة السورية في المفاوضات الجارية بين الطرفين، كيلا تنحصر نتائج المفاوضات على تحقيق مصالح الطرفين السياسية والعسكرية على حساب مطالب الأهالي ومستقبل المنطقة.
من جهتهما، فإن حكومة الشرع وقسد مطالَبتان بالشفافية الكاملة حول ما يحصل في أروقة المفاوضات، وتقديم تصريحاتٍ بشكلٍ دوري للسوريين، وعليهما أيضاً التواصل بعد كل جلسة تفاوض مع الخبراء والمجتمع المدني وممثلي المجتمع الأهلي، لتعريفهم بمصير المفاوضات والاستماع لتعقيب الأهالي.
رغم التفاؤل في سير المفاوضات وفق تصريحات الطرفين الشحيحة، إلّا أن هذا التواصل يجب ألّا يقتصر على قيادات الصف الأول والثاني، فالقيادات الأُخرى لها دورٌ مهم في التخفيف من الاحتقان وترسيخ مسار الحوار بين الأطراف ومواجهة حملات التحريض، وهنا يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دور الوسيط بين هذا المستوى من القيادات.
في نهاية المطاف، فإن هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية يجب أن تُجريا نقداً عميقاً لأدائهما خلال السنوات الفائتة، فإطلاق الوعود دون أُطرٍ زمنيّة، والتقرّب من المجتمع المدني والكفاءات، لم يعودا كافيين، وكذلك حل بعض الأجسام العسكرية. فالعقليات التي أدارت الجزيرة السورية وإدلب لم تعد ملائمة بعد التغيير التاريخي الذي حصل في سوريا، وهنا لا بد من مراجعة فكرية وسياسية جذرية، ووضع برامج قائمة على مبادئ وحدة الأراضي السورية والتعددية، والموازنة بين العلاقات الخارجية وحدود التأثير على القرار السوري، والإقرار وصون مبدأ حيادية الدولة.
موقع الجمهورية
————————————-
إعادة إنتاج الأمل: أي تشكيلات مدنية تنشط في الساحل السوري اليوم؟/ رهام عيسى
05-02-2025
أُنتِجَ هذا المقال في إطار زمالة بداية المسار للصحفيات السوريات.
* * * * *
تترددُ مقولاتٌ مثل «خصوصية الساحل» عند الحديث عن الساحل السوري وتغطية شؤونه، في إحالة إلى الارتباط الطائفي مع النظام السابق، والذي يحضر كعنوان أبرز لهذه الخصوصية على الرغم من وجود عوامل موضوعية أخرى. ساهمَ هذا الارتباط، الذي يحضر على المستوى الشعبي وبين أفراد السلطة الجديدة، في خلق حالة عامة يشوبها التوتر ممتزجاً بمشاعر الذنب والترقُّب لما سوف يأتي في المرحلة الجديدة. من هنا تبرز أهمية العمل المدني، ودوره التنظيمي وتأثيره على الخطاب والحياة الاجتماعية لسكان المنطقة، ومساهمته الممكنة في إبعادها عن خيار التكتّل الطائفي سعياً للأمان.
يسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على عمل بعض التجمّعات وكيانات العمل المدني التي ظهرت، أو عادت لتنشط، بعد سقوط النظام في الساحل السوري، وعلى أبرز التحديات التي تواجه عملها ورؤيتها للمرحلة القادمة.
تركة ثقيلة
تشهد البلاد اليوم تحوّلات جذرية، إضافة إلى ظروف معيشية صعبة وعدم استقرار أمني في بعض المناطق، ما يسبّبُ حالة عامة من القلق، ولكن مع تعقيد المشهد السوري قد لا يبدو مفاجئاً أن يترافق هذا القلق مع كثير من الأمل بمستقبل أفضل. ربما يكون ذلك هو ما شجَّعَ كثيراً من المثقفين والناشطين على محاولة توجيه هذا القلق وتأطيره ضمن تيارات وأحزاب وتجمعات مدنية سياسية وغير سياسية، تحاول فرض نفسها اليوم في الساحة السورية على أمل أن تُشكِّلَ عنصراً ضاغطاً على أي محاولات للتفرد بالسلطة أو البدء بالتأسيس لنظام استبدادي جديد.
استهدفَ النظام السابق أي شكل من أشكال العمل الجماعي المُنظَّم، كونه قد يشكل نواةً لتجمعات وحراكات مقاوِمة وساعية للتغير، ولذلك عملَ بشكل ممنهج على تقويض العمل المؤسساتي، وعلى تدمير كل جسم سياسي محتمل، مُفقِداً المجتمع القدرة على التواصل والعمل إلّا ضمنَ وصايته وتحت إشرافه وبما يخدم خططه ويحقق أهدافه. وقد ظهرت نتائج هذه السياسة مباشرة بعد السقوط، وما تبعه من فراغ سياسي ومؤسساتي اجتماعي، ما أوجبَ على الراغبين بالانخراط في أنشطة مدنية منظمة البدء تقريباً من تحت الصفر، أي من مرحلة إعادة إنتاج الأمل، بعد أن أدت سنوات الإقصاء والحرب والاعتقال والقمع الطويلة للإحباط والإحساس بعدم الجدوى.
مازن مصطفى، أمين المكتب السياسي في التيار المدني السوري، يعلّق على هذه النقطة: «يمكننا الحديث عن عشرات بل مئات الارتكابات التي قام بها النظام السابق، ولكن أعتقدُ أن الجُرم الأكبر كان اختيار رأس ذلك النظام لهذه الطريقة التي سلَّمَ بها السلطة، حيث تركَ البلاد في حالة من الفراغ السياسي المتعمد عبر تسليم السلطة بشكل فوضوي لكيانات غير مؤهلة لإدارة الدولة، وغير مستعدة لذلك، ما أدى إلى تفاقم الانقسامات والخوف من المجهول ونشر الذعر والفوضى وحالات الانتقام العشوائية».
لكن على الرغم من كل تلك التخوفات، هناك حماس ملحوظ في الشارع السوري اليوم لإعادة تنظيم نفسه. ولا ينفصل المشهد في الساحل عن المشهد السوري العام، فالعديد من التيارات الشعبية والسياسية والفكرية بدأت بتشكيل نفسها والإعلان عن برامجها.
في هذا السّياق نجدُ أنّه من المهم تمييز شكل عمل هذه التيارات والتجمّعات عن الأحزاب، كونها تمثل تجمّعاً جماهيرياً حول مطالب وأهداف محددة، ولا تهدف إلى تمثيلٍ في السلطة أو الوصول إليها أو المشاركة فيها بالضرورة، بل تسعى لممارسة دور الرقيب عليها والضغط على ممثليها.
تَجمُّع سوريا الديمقراطية هو أحد التجمّعات السياسية التي تشكلت بعد سقوط النظام في سوريا، وقد عّرفه الصحفي كمال شاهين أحد أعضائه المُؤسِّسين بأنه: «تجمع سياسي نشأ في مدينة اللاذقية بعد أسبوع على سقوط النظام السابق». يعتبر التجمع أنّ سوريا بسقوط نظام الأسد دخلت مرحلة جديدة تتطلب تضافر جهود جميع أبنائها لإعادة بناء مستقبل آمن للشعب السوري، بعد الآثار السلبية التي خلفها النظام. في هذا السياق، اجتمع ناشطون وشخصيات وطنية في اللاذقية لتأسيس هذا التجمّع.
لخّصَ شاهين أهداف التجمّع في حماية السلم الأهلي والأمن العام، والسعي لعقد مؤتمر شامل للحوار الوطني وإطلاق عملية الانتقال الديمقراطي، وإنهاء الاحتلالات والتدخلات الخارجية لضمان وحدة البلاد، والدفع لتطبيق القرار الأممي 2254 وتوحيد الجهود لمكافحة الاستبداد وضمان الحريات وحقوق الإنسان، والدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية بالتنسيق مع نقاباتها، ومناهضة التمييز بين الجنسين وتعزيز الثقافة السورية. التجمُّع مفتوح لجميع السوريين بمختلف مهنهم ومذاهبهم، ويسعى لبناء كتلة وطنية ديمقراطية.
ليس بعيداً عن هذه الرؤية، يتحدث أمين المكتب السياسي في التيار المدني السوري، مازن مصطفى، في شهادته للجمهورية.نت عن هذا التيار الذي بدأ عمله منذ عام 2012 ويضمُّ ما يقارب 30 ألف عضو حتى الآن. يسعى التيار على حد تعبيره إلى بناء دولة علمانية ديمقراطية قائمة على الحرية والمواطنة المتساوية والعدالة والمساواة، مع التركيز على استقلال القضاء، فصل السلطات، وضمان حقوق الإنسان. ويرى أنّ أي حراك يُعنى بالتغيير له أبعاد سياسية، والابتعاد عن السياسة قد يضعف الحراك ويفقده زخمه ويقلل من تأثيره. لذلك، يتمسّك التيار المدني السوري بدوره كفاعل سياسي ومدني يسعى لتحقيق تغيير شامل مبني على أسس وطنية وديمقراطية.
في مدينة صافيتا أيضاً تم الإعلان عن تشكل التيار المدني في صافيتا، وهو حركة شعبية لا صفة سياسية لها. يدعو التيار إلى قيام الدولة المدنية في سوريا، والتي تضمن المساواة الكاملة للمواطنين أمام القانون، وحرية التعبير والتعددية السياسية، وفصل السلطات الثلاث، وتداول السلطة. يعتمد التيار في عمله على التواصل والحوار مع المواطنين، بهدف تعريفهم على حقوقهم، ودفعهم للمطالبة بها، ضمن إطار جماعي منظم، إضافة إلى أهمية التفكير بوجودهم والتعبير عن أفكارهم دون خوف. يرى التيار أن الانتقال من حياة الظلم والعبودية لن يتم إلّا بوجود الرؤيا الواضحة والعزيمة الصادقة المبنية على أساس علمي أخلاقي حقيقي.
سؤال التثقيف السياسي
الإهمال الذي يسيطر على مناطق الساحل وعلى جميع الأصعدة جليٌّ للعيان، أسست حالة التفقير هذه لحصر هموم أهل المنطقة في تحصيل لقمة العيش، وتغييبهم عن حقوقهم الأساسية بشكل كامل.
لم يكن في عهد النظام البائد توازٍ في العلاقة بين التعليم والثقافة، وعلى وجه الخصوص ثقافة المواطنة، مقابل خطابٍ حكومي يُذكّر مواطنيه على الدوام بأفضال الدولة في تأمين الحد الأدنى من مقوّمات الحياة، في أوضح نموذج للآليات التي يذكرها كتاب مصطفى حجازي الشهير: التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور.
هذا السياق يطرح تساؤلاً عن كيفية تعاطي هذه التيارات مع هذا الواقع في الساحل، وحول وجود خطةٍ واضحة من قبل التيارات المدنية لنشاط تثقيفي يخصّ المواطنة والحقوق والواجبات والحريات العامة وما إلى ذلك، منعاً لتكرار الرضوخ الناجم عن التجهيل، وخاصةً مع انتشار عبارة: «بس بدنا الأمان»، وتَحوُّلها لخطاب شبه جماعي في الساحل.
بالنسبة لكمال شاهين: «لم يكن الساحل السوري منعزلاً عن السياق السوري ككل في علاقته مع النظام البائد. تفريغ الفضاء العام السوري من الشأن السياسي عملية مستمرة عمل عليها النظام طيلة سنوات حكمه على كامل الجغرافيا السورية. ومثلما انتفضت الجغرافيا السورية على النظام السابق فإنّ الساحل قد فعل. لقد ظهرت أوّل أشكال المعارضة السياسية لنظام الأسد الأب من الساحل وقد قمعها بشدة كبيرة، وملأ سجونه بمئات المناضلين من هذه المناطق، وعمل بدأب على ملاحقة ومضايقة عوائلهم. ومثله فعل نظام الأسد الابن حتى ساعة سقوطه».
وتابع: «تتطلب المرحلة الحالية والقادمة عملاً على تقريب السياسة والعمل العام من الناس، عبر مساهمتهم هُم في خلق النقاش حول مختلف المسائل التي يعتقدون بضرورتها الراهنة والمستقبلية، ليكون دور التجمُّع هنا إعادة السياسة إلى الفضاء العام بكامل حريتها وحضورها المعرفي والثقافي. في الأساس فإن الثقافة أداة فعّالة في بناء الوعي الجمعي وتعزيز الهوية الوطنية. وهي أيضاً وسيلة لتبادل الأفكار والقيم والمفاهيم التي تُشكِّل المجتمع. لذا، فإن إعادة السياسة إلى الفضاء العام تتطلب أيضاً إعادة الثقافة إلى مركز النقاش العام، بحيث يتمكن الناس من التعبير عن آرائهم ومخاوفهم وطموحاتهم».
وعقَّبَ مازن مصطفى على هذا السؤال بقوله: «لا يمكن إنصاف الساحل السوري عبر اختزاله في صورة نمطية تُوصَف بالجهل أو التخلف، إذ أن هذه المنطقة كانت وما تزال حاضنة لنخب فكرية ومثقفة ساهمت بإنجازات ثقافية وفكرية رغم التهميش الممنهج. لقد استخدم النظام السابق سياسات اقتصادية واجتماعية لتكريس الفقر والتهميش، ما جعل العلم والثقافة ملاذاً رئيسياً لأبناء المنطقة للهروب من براثن الإفقار، ومع ذلك، فإن الاستبداد والديكتاتورية كبّلت قدراتهم وأبقتهم في دائرة الصمت».
أشار محمد علي النجار في بحث بعنوان منظمات المجتمع المدني السوري: الجذور والواقع والمستقبل إلى الدور الأعظم للإشكالية الفكرية الناجمة عن ممارسات النظام السابق، والتي تسبق في أثرها دور الإشكالية السياسية. بالتالي سيكون الحديث عن أي نهضة سياسية حقيقية ناقصاً ما لم يتم العمل بدايةً على إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والفكرية، والتي تمنع حقيقة تشكل مؤسسات مدنية فاعلة تكون صلة وصل بين الشعب وممثليه من السياسيين بالشكل الذي يجدي نفعاً.
وأكَّدَ غدير غانم، عضو مجلس إدارة في مبادرة الحوار المدني في طرطوس، أن هناك محاولات حثيثة خلال الفترة القريبة للعمل على رفع الوعي والمعرفة وتطوير القدرات بشكل رئيسي للناشطين ثم المواطنين، وذلك «بهدف مساعدة المجتمع ككل لمشاركة في الحياة العامة، خاصةً وأننا أمام استحقاقات قادمة. هذا ما يجعلنا بحاجة ماسة للوعي ومساعدة من يمتلك المهارات المناسبة للوصول لأماكن صناعة القرار، وهذا العمل لا يخصّنا وحدنا بل نحن على تواصل دائم مع منظمات المجتمع المدني في سوريا بشكل عام، وحتى المنظمات خارج البلاد، بهدف توحيد الجهود لزيادة الوعي والإدراك لأهمية المشاركة في الاستحقاقات».
يشرحُ لنا مازن مصطفى عن آلية عمل التيار المدني السوري بما يتعلق بهذا الموضوع: «يسعى التيار إلى تبني برامج تعليمية شاملة، ويقوم بعقد ندوات فكرية بالتعاون مع أبناء الساحل السوري والنخب في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوعي الحقوقي وترسيخ مفاهيم العلمانية والمواطنة المتساوية كوسيلة لحماية المجتمع من التهميش وضمان استقراره».
من الممكن أن يقودنا هذا النقاش إلى نقطة تفكير حول مستقبل أي أحزاب سياسية ناشئة، وإلى أي مدى سيكون تأثيرها حقيقياً وناجحاً على أرض الواقع في ظل غياب عمل المؤسسات الاجتماعية القادرة وحدها على تعبئة الشعب وتوجيهه بالشكل الذي يجعله رقيباً على أي سلطة سياسية لا ممتناً وشاكراً لمجرد وجودها. ويصبّ هذا التوجه مباشرة في أهمية العمل على إعادة تمتين الروابط بين أفراد المجتمع، ونشاط أفراده ضمن منظمات ومؤسسات فكرية واجتماعية قبل الحديث عن بناء على أساس سياسي وعسكري وحزبي. وهنا يبرز تساؤل عن مدى عمل التيارات على توحيد قواها والتنسيق في بينها.
أجاب مازن مصطفى عن هذا التساؤل قائلاً: «بحكم عملنا منذ عام 2012، تربطنا علاقات وثيقة مع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية في دمشق وباقي المحافظات، والتنسيقُ ليس وليدَ سقوط النظام، لكنه أصبح أكثر إلحاحاً بسقوطه كضرورة استراتيجية لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية».
من الشعب وإلى الشعب
يلعب العمل الجماعي المُنظَّم دوراً ضامناً حتى في حالة الفراغ السياسي، لكنّ هذا لا ينفي أن تحقيق شروط هذا العمل على أرض الواقع من أبرز التحديات التي تواجه أي حركة بدأت اليوم تشكل نفسها، فالقاعدة الشعبية المتينة والمنضبطة ضمن المؤسسات هي أداة التغيير السياسي الأساسية.
عن ذلك يقول مازن مصطفى: «إن التغيير السياسي الحقيقي لا يتحقق إلا بوجود قاعدة شعبية واسعة وقوية، حيث تقوم الديمقراطية على مبدأ ’الشعب مصدر السلطات‘. ويرى التيارُ أن الانسجام الوطني القائم على رؤية سياسية شاملة ومُعلَنة هو المفتاح لبناء دولة ديمقراطية مستقرة، بعيداً عن الطروحات الطائفية أو المناطقية، فنحن اليوم أمام منعطفات مصيرية في مستقبل سوريا ولا يمكن ترك الأمور لمن يريدها طيفاً واحداً بدعوى (ضرورة الانسجام)!»
حتى الآن، أي بعد حوالي الشهرين على سقوط النظام، نجد أن الكثير من التيارات الراغبة بالإعلان عن نفسها تعيشُ حالة من الانتقال من اجتماع إلى اجتماع دون الوصول إلى نتائج أبعد من هذه الاجتماعات، عن ذلك يرى غدير غانم أنّ «القيود والمساحات الضيقة للعمل من أسباب الفشل، لكن يبقى ضعف التجربة هو السبب الرئيسي لهذا الفشل. إضافة للخطاب النخبوي الذي تقوده النخب، والذي أعتقدُ أنه خطاب منفصل عن الجمهور».
يتابع: «ربما، هو خطاب جيد لكن هناك ضعفاً كبيراً في الأدوات التي تُمكِّن هذه النخب من التواصل مع الجمهور الذي يميل للخطاب الشعبوي، وهذا حقيقة هي ما أدركته العديد من الجهات وعن طريقه تمكنت من استقطاب أكبر للجماهير. ولعلّ سمة الاستفراد والرغبة بفرض وجهات نظرها وعملها، يجعل هذه التيارات تنتهي عند الخطاب أو البيان الأول ثم تقف عاجزة عن فعل شيء».
هنا لا بدّ من التساؤل عن أهمية إجراء دراسات ومُراجعات لأسباب الفشل لتجنب الوقوع بها، وفي هذا السياق تحدَّثَ مازن عن تجربتهم في التيار المدني السوري: «أجرى التيار المدني السوري منذ تأسيسه عام 2012 مراجعات دورية لدراسة أسباب تعثُّر الحركات المدنية السابقة، من خلال المؤسسة السورية للدراسات والتنمية (التابعة للتيار) والتي تم حظر عملها بسبب نشاطها السياسي عام 2018 (بعد قيام المؤسسة بتبني حراك ضد قيام الرئيس السابق بـ 62 مخالفة دستورية في إصداره للمرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بتنظيم عمل وزارة الأوقاف، وأدى ذلك الحراك لإلغاء المرسوم حينها). وأبرزُ العوامل التي أدت إلى فشل تحركات المجتمع المدني عموماً هي: غياب الموارد المالية، التضييق الأمني والملاحقات السياسية، نزعة الزعامة الفردية وضعف الهياكل التنظيمية، وبالتأكيد الحظر المفروض على النشاط السياسي المدني. اليوم، يتمتع التيار المدني السوري بهيكلية تنظيمية محوكمة، وكوادر نخبوية مؤهلة، ما مَكَّنه من بناء قاعدة جماهيرية مُتنامية قادرة على مواجهة تحديات العمل المدني والسياسي في بيئة مضطربة».
ويرى كمال شاهين أنّ «الحديث عن المشاركة في عملية التغيير السياسي يتطلب وجود قاعدة جماهيرية فاعلة قادرة على التأثير وإحداث التغيير. هذه القاعدة ليست مجرد تجمع عشوائي، بل يجب أن تكون مبنية على أسس قوية من الوعي والانتماء والمشاركة الفعالة. تقتضي هذه العملية طويلة المدى التفكير في عدد كبير من النقاط الضرورية للعمل. نختصر هنا ثلاثاً منها تتمثل في: بناء تحالفات مع الأحزاب والتيارات السياسية التي بدأت تتشكل في سوريا، بما يشمل تبادل الخبرات والموارد، وتنظيم فعاليات مشتركة لزيادة الوعي وتعزيز المشاركة، وهو ما قام به التجمُّع في أول نشاط جماهيري له في اللاذقية عبر ندوة حوارية مع ’حركة معاً لأجل سوريا جديدة‘ تناولت موضوع السلم الأهلي والانتقال الديمقراطي، وحضرها قرابة مئتي مشارك ومشاركة. تتمثل النقطة الثانية في دعم الشباب والنساء، ويبذل التجمُّعُ جهداً لاستقطاب الشباب والنساء للمشاركة في العملية السياسية، من خلال حضورهم في قلب التجمع ودعمهم في تشكيل قيادات جديدة. والنقطة الثالثة هي تطوير استراتيجيات فعّالة للتواصل مع القاعدة الجماهيرية، سواء عبر الفعاليات المباشرة أو من خلال الحملات الإعلامية التي تركز على قضايا تهم المجتمع وتعكس همومه وقضاياه الحالية وعلى رأسها القضايا المعيشية والأمنية».
الطائفية في مواجهة الفراغ
في ظل الغياب شبه التام للمؤسسات الاجتماعية، وفقدان صلة الوصل بين القيادة السياسية وبين عموم الناس، شهدت منطقة الساحل تعويماً للروابط الطائفية بمجرد سقوط النظام، وتكتل جزء من الناس خلف المشايخ وبياناتهم التي أثارت جدلاً واسعاً وكانت ملأى بالتناقضات.
وقد أشار كمال شاهين إلى ذلك مؤكداً أن حالة الفراغ السياسي، التي فرضها النظام السابق، ساهمت بشكل كبير في تعويم الروابط الطائفية كأداة لتجميع الناس. فعندما يغيب الفضاء السياسي الفعّال والمُستدام، تلجأ المجتمعات إلى الروابط الطائفية أو القَبَلية كوسيلة للتعبير عن الهوية والانتماء، ما يُعزّز الانقسامات ويعيق بناء مجتمع متماسك.
وعن سؤالنا عن الحلول المقترحة من قبل تجمع سورية الديمقراطية، أشار إلى أهمية اتخاذ عدة خطوات، لتقليص هذه الروابط الطائفية وتعزيز الانتماء إلى تيارات وأحزاب سياسية تطالب بحقوقها، والعمل على تعزيز التعليم والتوعية وتشجيع التفكير النقدي، وعلى خلق فضاءات حوارية ودعم الأحزاب السياسية كبديل للروابط الطائفية، وتحفيز المشاركة المدنية في الحياة العامة ومحاربة خطاب الكراهية بمساعدة الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني والإعلام.
في السياق ذاته، يُشدِّدُ مازن مصطفى على أهمية العمل المدني كبديل مُستدام للتكتلات الطائفية، مؤكداً أن الهوية الوطنية الجامعة وعلمانية الدولة هي السبيل الوحيد لضمان استقرار سوريا بعيداً عن الاصطفافات الطائفية الضيقة.
وبحسب تعبيره: «أظهر المجتمع السوري وعياً جمعياً بارزاً في التصدي لمحاولات تأجيج الطائفية، ويتجلى ذلك في استضافته المتبادلة بين مكوناته المختلفة خلال الأزمات، وهنا لا بد من الإشادة بهذا الوعي الجمعي لدى المجتمع السوري بغالبيته، والذي يدير نفسه بنفسه حتى الآن إذا صح التعبير. أما عن تعزيز الروابط الطائفية، فهذا يحدث عند البعض من الجهلة والمنتفعين منه فقط، فلماذا نريد اليوم تكريس فكر أولئك وننسف فكرة أن الغالبية من كل مكونات الشعب السوري تنأى بنفسها عن تلك التوصيفات والاصطفافات، وهذا يتوضح لكم من تزايد عدد التيارات المدنية الناشئة مؤخراً على أقل تقدير. هنا لا بد من الإشارة إلى أن تشكيل الأحزاب والتيارات المدنية ليست بديلاً عن مخاطر التكتلات الطائفية، بل هي حالة تنظيمية تمنع وقوع البلاد في فراغ سياسي، لأن العمل المدني حالة سياسية تعددية وتنظيمية دائمة بينما التكتل الطائفي ردُّ فعل نفسي مؤقت لا جدوى منه».
يعتقد غدير مصطفى أنّ النظام ليس وحده السبب وراء حلول الطائفة بديلاً عن الأحزاب والمؤسسات، فـ«المجتمع لا يملك هوية وطنية جامعة، ومشكلة الهوية هذه مشكلة عابرة لكل الأنظمة التي حكمت سوريا». وعلى عكس الشائع، يرى أن النظام في مكانٍ ما ليس متسبباً في تجذُّر هذه الطائفية بقدر ما سعى لإنهاء هذا الانفصال، «عن طريق تجميع الأقليات ضمن إطار إسلامي سنّي، وهذا التجميع هو شعار كل ديكتاتور، فالتشتت يُقلق الدكتاتور، لكنه بالطبع فشل في هدفهو إذ بسبب ترهل كل المؤسسات التي يملكها لم يستطع بناء هوية جامعة للسوريين».
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن المواطنين يبحثون الآن عن الشعور بالأمان، وهذا ما يجعلهم يصطفون خلف أي تجمُّع يحاول الدفاع عنهم أو المطالبة بحقوقهم، حتى لو كان خطابه طائفياً، وخاصة بعد توثيق الكثير من حالات القتل والتصفية والتسريحات التعسفية والخطابات المحرضة المليئة بالعبارات الطائفية، فهل هناك توجه من قبل التيارات المدنية لاستيعاب خوف الناس والسعي للمطالبة بحقوقها؟
علَّقَ مازن مصطفى على هذا التساؤل: «تشكل الانتهاكات والتسريحات التعسفية والاعتقالات العشوائية (بعد إصدار ما سمي بالعفو العام) أحد التحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع السوري، وإن استمرار استخدام مصطلحات مثل ’حالات فردية‘ و’قانون الثورة‘ لتبرير هذه التجاوزات يُهدد بتفكيك المجتمع السوري ويؤدي إلى نتائج كارثية. يتبنى التيار المدني السوري آلية توثيق دقيقة وموضوعية للانتهاكات، بما فيها قضايا التسريح التعسفي (والتي نعتبرها انتهاكاً أيضاً)، كما ندعم الحراك الشعبي السلمي الهادف إلى إلغاء القرارات غير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين. ويرى التيار أن مواجهة هذه الممارسات لا يمكن أن تتم دون وجود قضاء مستقل وفعّال، قادر على إنصاف الضحايا وإرساء دولة القانون بدلاً من سلطة الأمر الواقع التي تُدار بعقلية الفصائل حتى الآن (وهذا أكبر انتهاك بحق سوريا والسوريين دون استثناء)».
وقال كمال شاهين: «شمل التسريح التعسفي غالبية المحافظات السورية وليس الساحل فقط. أما الانتهاكات التي تقول السلطة الجديدة (سلطة الأمر الواقع) إنها فردية، فإنها بحاجة لجهاز متكامل للقيام بتوثيقها يتضمن محامين وناشطين وعاملين في مجال التوثيق، وغير ذلك من أدوات بصرية وقانونية وهي مهمة ليست سهلة أبداً. لا يمكن إغفال وجود الانتهاكات كما لا يمكن إغفال عمل السلطة الجديدة على محاولة متابعتها بسرعة في غالب الأحيان. إنّ بنية حكومة الأمر الواقع التي تحتوي عشرات الفصائل، التي كانت إلى وقت قريب متنازعة فيما بينها، تجعل من الفصل بين الحالات الفردية والانتهاكات عملية حقوقية وسياسية، وفي الوقت الراهن فإن التجمُّع لا يمتلك هذه الأدوات، مع الإشارة إلى أن بيانات التجمع التي صدرت حتى الآن تتابع ما يجري في المحافظات السورية كافةً، وقد رفض التجمُّع التسريح التعسفي ودعا إلى وقفات تضامنية مع المفصولين عن غير وجه حق». وعن رؤية معينة للحلول، أجاب بأن الحل يجب أن يكون لكل سوريا ضمن جغرافياتها كلّها وليس لمنطقة واحدة، ويقع هنا موضوع السلم الأهلي والانتقال الديمقراطي على رأس القائمة.
التحديات الاقتصادية والمعيشية
الظرف المعيشي الشاق، في الساحل وفي غيره، يحتل مكانة بارزة في أي نقاشات سياسية تدور الآن. وإضافة إلى الفقر هناك تردٍ شديد في الواقع الخدمي، يفرض على أي مبادراتٍ وأنشطة أن تأخذه بعين الاعتبار.
عانت قرى الساحل السوري من استراتيجيات تفقير ممنهجة بحسب مازن مصطفى، «شملت التضييق على المزارعين، منع الاستثمارات، الإهمال التنموي، وضعف الخدمات، والترويج لهيمنة وإجرام آل الأسد كأداة للقمع والتخويف. أسهمت هذه السياسات في تعزيز الفجوة بين مكونات المجتمع السوري وخلق صورة مشوهة عن أبناء الساحل، وهذا ما ندفع ثمنه الآن بغير ذنب، ونعمل على تغيير هذه الصورة النمطية المغايرة كلياً للواقع».
وأضاف: «يسعى التيار المدني السوري إلى تفعيل مشروعات اقتصادية صغيرة ومتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي في المناطق المُهمَّشة، ولكن هذا مرهونٌ بالاستقرار الأمني، لذلك نؤكد على ضرورة استتباب الأمن وبسط سيادة القانون كأساس لخلق بيئة استثمار جيدة تُفضي إلى تحسين الوضع المعيشي».
يتفق غدير غانم مع هذا الرأي: «عمل النظام على إفقار الساحل من خلال قتل كل مصادر التنمية باستثناء الوظائف والحالة العسكرية. لا مشاريع ضخمة لا استثمارات، وهذا ما ساهم في انعدام موارد الدخل ما اضطر كثيرين للالتحاق بالخدمة العسكرية. ولا بدَّ من الإشارة إلى الحملة الممنهجة التي كان يتبعها النظام في بداية الأزمة، والتي كانت تهدف لتخوين الشباب ممّن يتقاعسون عن الالتحاق بالجيش ويبحثون عن فرصة للسفر، جاعلاً منهم وقوداً لحربه».
تبرز هنا تخوفات كثيرة من العودة للعزف على وتر الفقر من قبل السلطة الحالية، واستغلال حاجات المواطنين الأساسية لتحييد أي عمل خارج العمل الخدمي، حتى أننا لاحظنا حملات حقيقية تهدف لتسخيف المطالب بقيام الدولة المدنية والعدالة والمساواة والحريات، عبر تحويلها إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمفاضلة بينها وبين الخدمات بهدف التقليل من أهميتها، فصرنا نسمع عشرات المرات يومياً عبارات من نوع «عم نموت من الجوع وبدهم دولة علمانية».
قد تكون هذه المرحلة من تاريخ بلدنا، على مشاقها، هي الأكثر مناسبة لتأسيسٍ سياسي جديد على أرض صلبة، مع ضرورة تضافر الجهود الشعبية لصالح هذا التأسيس، ولصالح قيام نظام سياسي على مبادئ العدالة واحترام الحريات وتداول السلطة.
موقع الجمهورية
——————————–
قراءة في خطابي رئيس الجمهورية/ حسان الأسود
2025.02.06
تنشد هذه المقالة الإضاءة على أهمّ ما ورد في خطابي رئيس الجمهورية الأخيرين، فقد حدّد السيد أحمد الشرع في كلمته أمام ممثلي القوى العسكرية المجتمعة يوم 29/1/2025 أولويات سوريا الراهنة بـما يلي:
ملء فراغ السلطة.
الحفاظ على السلم الأهلي.
بناء مؤسسات الدولة.
إنشاء بنية اقتصادية تنموية.
استعادة سوريا مكانتها الدولية والإقليمية.
وفي اليوم التالي، أي بتاريخ 30/1/2025 خاطب الرئيس الشعب السوري، وتطرّق لنقاط شديدة الأهمية باعتبارها خطوات تنفيذية محددة، هي:
تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى الوصول إلى مرحلة انتخابات حرّة نزيهة.
العمل على تشكيل لجنة تحضيريه لاختيار مجلس تشريعي مصغّر يملأ الفراغ في المرحلة الانتقالية.
الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول البرنامج السياسي القادم.
وبعد إتمام هذه الخطوات، سيتم إصدار إعلانٍ دستوري يكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية، ثم أوضح أنّه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على مجموعة من العناوين، هي ذاتها التي أعلنت عنها الفصائل في مؤتمر إعلان النصر مع بعض التركيز، وهي:
تحقيق السلم الأهلي.
ملاحقة المجرمين ممن اختبأوا داخل البلاد أو فرّوا خارجها عبر عدالة انتقالية حقيقية.
إتمام وحدة الأراضي السورية، كل سوريا وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.
بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشى.
إرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة لتحسين الظروف المعيشية واستعاده الخدمات الأساسية المفقودة.
الممكن حسب الأولويات، تبدو جميع النقاط المحددة في برنامج عمل الرئيس السوري أولوية قصوى بحدّ ذاتها أو على الأقل لفئات وازنة من الشعب السوري، لكنّها في المجمل تصبّ في خانة إعادة بناء سوريا من الصفر تقريباً.
الحكومة الانتقالية
تعدّ الحكومة الانتقالية أولى ساحات اختبار البرنامج الرئاسي، فهي عنوان أولي لوجه سوريا الجديدة، فإذا ما كانت شاملة ومنصفة وعادلة في توزيع المهام والمسؤوليات، فإنها ستفتح باب الأمل أمام الجميع للمساهمة الإيجابية في العمل.
يتطلّب عنصر التشميل وجود توازن بين الرجال والنساء، ونعتقد أنّ هذا الأمر سيؤخذ بالحسبان مع اعتماد مبدأ الكفاءة، لكن قد لا تلبي النسب طموحات الجميع، فالخلافات ما تزال بيّنة في رؤية السوريين والسوريات للأدوار التي يمكن أن تلعبها النساء في المجتمع السوري.
من المتوقّع أن تكون نسبة الشباب كبيرة في تشكيلة هذه الحكومة، فالمقدمات توحي بذلك، خاصّة وأنّ كوادر حكومة تسيير الأعمال كانت من هذه الفئة عموماً.
تتوفّر سوريا على كفاءات إدارية كثيرة، المشكلة أنّ استقطابها من الخارج يقتضي تعويضها بما يعادل الرواتب التي تتقاضاها في بلاد المهجر أو على الأقل ما يقاربها، وهذه إحدى التحديات التي تقف عقبة كأداء أمام تشكيل حكومة كفاءات.
ثمّة مشكلة حقيقية في جميع الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة تتمثل في تفشّي الفساد، فانعدام قيمة الدخل من جهة، واتباع سياسة ممنهجة لتخريب النفوس من خلال تثبيت مبدأ المحسوبيات والرشى من جهة ثانية، أفقدت المواطنين الثقة بكل هذه المؤسسات. إنّ الوصول إلى كادر إداري نظيفٍ وكفء في الوقت ذاته أمرٌ في غاية الصعوبة الآن في سوريا.
من تحديات التشميل في تشكيل الحكومة الانتقالية مبدأ المحاصصة، وهذه ستكون مقتلًا وقنبلة موقوتة إذا ما تمّ اعتمادها على الطريقتين العراقية أو اللبنانية.
تتميز سوريا بتعدد قومي وديني ومذهبي، ومحاولة إرضاء الجميع على هذه الأسس ستعني بالضرورة خلق حالة عبثية ستؤخر بناء الدولة وستعوق رتق الهُويّة الوطنية. الحلول متوفرة بكل تأكيد، ويمكن مراعاة كل هذا التنوّع من خلال الأخذ بمعيار الكفاءة مع تثقيل العناصر الأخرى كلما وجدت وكلما أمكن ذلك.
ستتسلّم الحكومة الانتقالية أنقاض دولة، وهذا بحد ذاته عبء كبير، فمن أين يمكنها أن تبدأ مع نقصٍ حادٍ في التمويل، وكيف لها أن تنجز أي تقدّم مع ضغط الأولويات؟ سيكون عليها إعادة بناء الأنظمة التشغيلية للدولة بكل تفرعاتها، الحقوقية والقانونية والقضائية والمالية والمصرفية والتجارية والخدمية والرقابية، فلا شيء سليم من هذه المنظومات التي بنيت على أسس باطلة من الفساد، وانعدام الكفاءة، وسوء المتابعة، والمحسوبات.
من التحديات الكبيرة أمام الحكومة الانتقالية ترتيب الأولويات، فهل تبدأ من تأمين البيئة المناسبة لعودة المهجرين والنازحين، أم تبدأ بتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وأمن وفرص عمل، أم تبدأ من تحديات العدالة الانتقالية وموازنتها بين ملاحقة المجرمين وتعويض الضحايا وإصلاح المؤسسات، والقائمة تطول.
المجلس التشريعي
تتحدد مهام المجلس التشريعي المصغر في المرحلة الانتقالية بسنّ القوانين المؤقتة الضرورية لتسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويجب أن تستند هذه القوانين إلى الإعلان الدستوري، ويجب أن تكون متوافقة معه، فالنظام الانتخابي مثلًا لا بدّ أن يتناسب مع العقيدة الأساسية للدولة الجديدة، فالرؤية الدستورية لشكل الدولة وشكل نظام الحكم تأتي تكثيفاً قانونياً لفلسفة الدولة وللعقد الاجتماعي المأمول إنشاؤه.
كذلك ثمة قوانين كثيرة لا بدّ منها لتنظيم الحياة خلال المرحلة الانتقالية، مثل قانون الأحزاب وقانون الصحافة والإعلام وقانون التجنيد والسلطة القضائية وغيرها من القوانين التي لا تستقيم أمور الدولة من دونها.
الطريقة التي سيتمّ بها تشكيل المجلس التشريعي المصغّر مهمة جداً وتعبّر عن مدى الالتزام بالوعود المطروحة في البرنامج الرئاسي، فإذا ما كانت اللجنة من لون واحد، فيصعب تصديق أن تكون اختياراتها متعددة الألوان. إنّ تغليب المصلحة الوطنية يقتضي النظر إلى تنوّع العقائد والأفكار والانتماءات والهويات الفرعية في سوريا، وهذا يعني بالضرورة تنوّع الاحتياجات التي يجب أن تلبيها التشريعات الصادرة عن هذا المجلس المصغّر.
مؤتمر الحوار الوطني
أوضح الرئيس الشرع أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول البرنامج السياسي القادم. ونحن نرى أنّ مهامه يمكن أن تشمل التوافقات السورية حول كثير من القضايا المصيرية.
فالحوار يمكن أن يمتدّ على طول الفترة الانتقالية ليشكّل بخلاصته التوافق السوري الذي يمكن تسميته العقد الاجتماعي الجديد.
إنّ مشاركة أطياف متعددة وواسعة من الشعب السوري تغطي كل المجموعات القومية والدينية والطائفية والمذهبية من جهة، وتشمل كل التيارات السياسية السورية من جهة ثانية، يجعل من الممكن أن يدخل السوريون والسوريات في حوار وطني واسع ومديد، ويؤدي من حيث النتيجة إلى تمتين دعائم الهوية الوطنية الناشئة.
نحن نعتقد أنّ إحدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد تكون إنشاء لجنة سورية متخصصة لكتابة الدستور السوري الدائم، فيمكن لأعضاء المؤتمر بعد خوضهم جولات عديدة أن يفرزوا من بينهم الكفاءات القادرة على تمثيل كل المطالب السورية من الدستور السوري، وهذه المجموعة المنتقاة يمكن أن تعمل على وضع مسوّدة دستور دائم يتم عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
من المهم أن تتم تغطية جلسات الحوار الوطني عبر الإعلام وبشكل مفصّل حتى يكون لدى السوريين جميعًا منصة للمشاركة والتفاعل.
تلفزيون سوريا
—————————————
مقابلة الشرع على تلفزيون سوريا.. هل تكفي الطموحات لتجاوز الأزمات؟/ أحمد زكريا
2025.02.06
في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا بتاريخ 3 شباط/فبراير 2025، خرج الرئيس السوري أحمد الشرع ليقدم رؤيته الشاملة حول المرحلة المقبلة التي ستشهدها سوريا على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية.
المقابلة جاءت في وقت حساس يشهد فيه البلد تحولات جذرية بعد سنوات من الصراعات والأزمات المتراكمة، ومن خلال استماعي الكامل لهذا اللقاء وتحليل محتواه، يمكن القول: إن كلام الشرع لم يكن مجرد تصريحات سياسية تقليدية، بل كان عبارة عن خطاب استراتيجي يعكس رؤية مدروسة وطموحة لبناء دولة جديدة قائمة على أسس العدالة الانتقالية، الاقتصاد الحر، والحوار الوطني.
من أبرز النقاط التي طرحها الرئيس الشرع في حديثه هو التوجه نحو اقتصاد حر ومنافسة تنافسية قوية.. هذه الرؤية ليست بعيدة عن السياق العالمي الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
الشرع أكّد أن الفشل الذي شهدته مؤسسات الدولة في العهد السابق كان نتيجة للفساد وعدم الحس بالمسؤولية، وهو ما أدى إلى انهيار القطاع العام وتردي الخدمات الأساسية، لذلك، يبدو أن الحل الذي يطرحه يتمثل في الخصخصة التي قد تعيد الحياة لتلك المؤسسات عبر إدخال الخبرات الاقتصادية الحديثة ورأس المال الخاص.
ما يميّز هذا التوجه هو تركيزه على تحقيق غايتين أساسيتين: توفير فرص عمل للشباب السوري وتحقيق أرباح لرجال الأعمال، وهذا النهج ليس فقط حلًا اقتصادياً، بل هو أيضاً وسيلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال القضاء على البطالة، وهي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
ومع ذلك، يجب أن نتساءل: هل سيكون هناك إطار تشريعي صارم يضمن عدم استغلال هذا الانفتاح الاقتصادي لصالح فئات معينة؟ وهل ستكون هناك آليات شفافة لحماية حقوق العمال وضمان توزيع عادل للثروات؟
أحد المحاور الرئيسية التي تحدث عنها الشرع هو المؤتمر الوطني المرتقب، الذي سيشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الحوار الوطني بين مختلف المكونات السورية، ومن الواضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى وضع توصيات شاملة لكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في بناء نظام سياسي يعبر عن إرادة الشعب السوري ويحقق العدالة الانتقالية.
الشرع أكد على أهمية محاسبة مجرمي الحرب من خلال محاكم عادلة، مما يشير إلى التزامه بمبادئ العدالة وعدم الانجرار إلى ثقافة الانتقام الفردي، وهذا النهج مهم للغاية لأنه يعزز السلم الأهلي ويضع حدًا لدوامة العنف والكراهية، ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يتطلب ضمانات دولية وإقليمية لدعم العملية السياسية وحمايتها من أي تدخلات خارجية قد تعرقل مسارها.
على الصعيد الخارجي، بدا واضحاً أن الشرع يعمل على تعزيز العلاقات مع الدول الإقليمية والدولية، خاصة بعد زيارته الأخيرة للسعودية، وهذه الخطوة ليست فقط دبلوماسية، بل هي استراتيجية تهدف إلى دمج سوريا مرة أخرى في المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار، فالعلاقة مع السعودية، التي كانت تاريخياً معقدة، قد تكون مؤشراً على بداية صفحة جديدة من التعاون العربي السوري.
لكن هنا أيضاً يظهر تساؤل مهم: كيف يمكن لسوريا أن توازن بين مصالحها الوطنية وبين الضغوط الدولية والإقليمية؟ وهل ستتمكن من الحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها السياسي في ظل هذه التحالفات الجديدة؟
ورغم الشمولية التي طغت على حديث الشرع، إلا أن هناك ملفات مهمة غابت عن الحوار أو لم تُناقش بالتفصيل الكافي، ومن أبرز هذه الملفات:
الإعلام: إذ يعتبر الإعلام أداة أساسية في بناء الوعي المجتمعي وتوجيه الرأي العام، وغياب الحديث عن كيفية تطوير الإعلام السوري (المتلفز أو المقروء) يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الإعلامية في المستقبل.
“قسد وداعش”: ملف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ووجود تنظيم “داعش” ما يزال معقدًا للغاية بسبب التداخل الدولي في هذا الملف، والشرع لم يتطرق بشكل مباشر إلى كيفية التعامل مع هذه القوى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الخطط المستقبلية للتعامل مع هذه التحديات الأمنية.
الأمن القومي: رغم أهمية الأمن في استقرار الدولة، إلا أن الملف الأمني لم يأخذ المساحة الكافية في الحوار، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية وتدريب كوادرها على أسس وطنية هو أمر حيوي لبسط السيطرة على كامل الأراضي السورية.
لا شك أن حديث الرئيس الشرع يعكس رؤية طموحة لمستقبل سوريا، لكنه يأتي في سياق تحديات كبيرة ومعقدة، ونجاح هذه الرؤية يتطلب أكثر من مجرد خطط وأفكار؛ فهو يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، دعم شعبي واسع، وتعاون دولي وإقليمي، كما أن نجاح المرحلة الانتقالية يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين المصالح المختلفة والحفاظ على هوية الدولة السورية.
ورغم أن مقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع على تلفزيون سوريا قدّمت رؤية طموحة للمستقبل، إلا أن العديد من المحللين والمتابعين أشاروا إلى غياب بعض النقاط الجوهرية التي كان من الضروري التطرق إليها لضمان شمولية الخطاب وإظهار جدية التعامل مع الملفات الشائكة، وتشمل هذه النقاط قضايا مصيرية مثل العدالة الانتقالية، ملف المفقودين والمعتقلين، السقف الزمني للحوار الوطني، شكل الدولة المستقبلية، دور الإعلام، الحلول البديلة لملف “قسد”، وأخيراً الثغرات الأمنية.
ورغم إشارة الشرع إلى أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاكم عادلة لمجرمي الحرب، لكنه لم يوضح كيفية تشكيل هذه المحاكم وما إذا كانت ستكون وطنية بالكامل أم أنها ستستعين بخبراء دوليين.
المحللون يرون أن غياب تفاصيل واضحة حول آلية تشكيل هذه المحاكم قد يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن عدم وجود ضمانات قانونية ودولية قد يؤدي إلى تسييس القضاء أو استغلاله لتحقيق مصالح سياسية.
ملف المفقودين والمعتقلين يُعد أحد الجروح النازفة في المجتمع السوري، حيث ما تزال آلاف العائلات تبحث عن ذويها من دون جدوى، وغياب أي إشارة إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة تتولى هذا الملف يُعتبر نقطة ضعف كبيرة في خطاب الشرع.
وهنا يؤكد المحللون على أن إنشاء هيئة كهذه ليس فقط واجباً إنسانيا، بل هو أيضاً خطوة أساسية لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، خاصة وأن هذا الملف يمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية الحكومة في التعامل مع الإرث الثقيل للأزمة.
الرئيس الشرع أشار إلى أن المؤتمر الوطني سيستغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات لوضع دستور جديد وإجراء الانتخابات، لكن هذا التوقيت يبدو طويلاً بالنسبة لكثيرين، خاصة في ظل الحاجة الملحة لاستعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهنا يتساءل المحللون: هل هناك حاجة فعلية لهذه الفترة الطويلة؟ وهل يمكن تقليصها لتجنب إطالة حالة اللايقين التي يعيشها الشعب السوري؟ تحديد سقف زمني واضح ومحدد يعد أمراً حاسماً لإدارة التوقّعات وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
أحد أبرز التحديات التي لم يتطرق إليها الشرع بشكل مباشر هو تحديد شكل الدولة والنظام السياسي المستقبلي، وهل سيكون النظام إسلامياً مدنياً أم علمانياً؟ وهل سيتم الأخذ بعين الاعتبار تنوع الهوية السورية الثقافية والدينية؟
غياب إجابة واضحة على هذه الأسئلة قد يؤدي إلى تضارب في الرؤى بين مختلف المكونات السورية، خاصة وأن هذا الموضوع يمثل قضية جوهرية في أي عملية سياسية انتقالية، وهنا يرى المحللون أن تقديم رؤية واضحة حول هذا الموضوع سيكون حاسماً في بناء توافق وطني.
الملف الأمني يُعتبر الأولوية القصوى لأي دولة تسعى لاستعادة سيطرتها على كامل أراضيها، ومع ذلك، غاب عن اللقاء أي حديث عن الثغرات الأمنية الحالية وهل تعود إلى نقص في العنصر البشري أم لأسباب أخرى مثل الفساد أو ضعف التدريب، وهنا المحللون يرون أن معالجة هذه الثغرات تتطلب استراتيجيات واضحة لرفد المؤسسات الأمنية بالكفاءات البشرية وتدريبها على أسس وطنية بعيدًا عن الانتماءات الطائفية أو الحزبية.
في المجمل، يمكن القول: إن حديث الرئيس الشرع يعكس رؤية طموحة لمستقبل سوريا، لكنه يأتي مع غياب واضح لبعض النقاط الجوهرية التي كانت تستحق المزيد من الاهتمام.
هذه النقاط ليست مجرد تفاصيل جانبية، بل هي قضايا مركزية قد تحدد نجاح أو فشل المرحلة الانتقالية، ولتحقيق الأهداف المرجوة، يجب على الحكومة أن تكون أكثر شفافية ووضوحاً في معالجة هذه القضايا، وأن تعمل على بناء ثقة الشعب السوري من خلال خطوات ملموسة تتجاوز الكلمات إلى التنفيذ الفعلي.
تلفزيون سوريا
——————————————–
كيف تبدو روسيا في سوريا ما بعد الأسد؟/ عمار جلّو
الخميس 6 فبراير 2025
في إشارة لإمكانية تجاوز عقدة الدعم القاتل من قبل موسكو لنظام الأسد البائد، وصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال زيارة أجراها إلى دمشق مؤخراً، برفقة مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، وصف المحادثات مع قادة سوريا الجديدة بأنها كانت “بناءة”.
قبلها، أشارت موسكو لنقل الرئيس السوري المخلوع لصلاحياته واستقالته من منصبه قبل مغادرته سوريا، في خطوة استباقية تفسح لها المجال للتواصل مع السلطات الجديدة، والتي يُشاع أنها أبرمت اتفاقات مسبقة مع موسكو، قبل أو أثناء مسيرها إلى دمشق، بجانب الحديث عن اتفاق يعتريه الغموض بين ممثلي روسيا وتركيا وإيران خلال اجتماع الدوحة في 6 كانون الأول/ديسمبر، يقضي بضرورة امتناع المعارضة السورية عن استهداف القوات العسكرية الروسية وقواعدها.
أياً يكن، تصرّفت السفارة الروسية في دمشق بهدوء خلال العملية العسكرية التي أطاحت بنظام الأسد الحليف، وتحاول الآن الاعتماد على السلطة الناشئة، والتي تتكون من معارضة حاربتها سابقاً، لضمان أمن جنودها وأصولها العسكرية المتبقية، مع أمل السماح لها بالاحتفاظ ببعض الوجود على الأقل في سوريا، حيث تمثل خسارة هذه القواعد ضربة قاسية لطموحات روسيا الجيوسياسية، والتي حاولت من خلالها إبراز قوتها في المنطقة مع رفع مكانتها الدولية، بجانب كونها مراكز لوجستية استراتيجية لعملياتها في دول القارة الإفريقية، والتي عزّزت موسكو نفوذها فيها مع تقويض المصالح الغربية.
كما أن توثيق علاقاتها مع حكومة دمشق الناشئة، سيجدّد اعتماد الأخيرة على أنظمة الأسلحة الروسية، مع إمكانية إعادة الوزن للدور الروسي في ضبط إيقاع التنافس الإقليمي المكتوم أو المعلن، بين أفرقاء المعادلة الشرق أوسطية.
ورغم الضربة التي تعرّضت لها روسيا بإسقاط النظام السوري، إلا أن لدى موسكو أوراق مساومة في تعاملاتها مع النظام الجديد، ومنها القمح والنفط، حيث تشكّل روسيا المورّد الرئيسي للقمح إلى سوريا، وهو ما يمكن استخدامه كورقة مهمة في مفاوضات مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا، بجانب إمكانية تثقيلها بمادة النفط، عبر استغلال موسكو للنقص الحاد بالنفط في سوريا، من خلال تقديم المساعدة في هذا الحيز مقابل مكاسب سياسية. بجانب خدمات سياسية ودبلوماسية قد تقدمها موسكو، أو تعرض تقديمها، كالاعتراف بالحكومة الناشئة مع حشد الاعتراف بشرعيتها، أو دعم مواقفها في مجلس الأمن الدولي، وسواهما من خدمات، أقلها إمكانية تحقيق التوازن ضد التأثير المفرط للقوى الفاعلة في سوريا ما بعد الأسد.
من جانبها، لدى الحكومة السورية الجديدة أسبابها المنطقية لإعادة النظر في العلاقة مع روسيا، رغم صعوبة تبرير ذلك أمام الشعب السوري، حيث أبدى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، استعداداً للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية، واصفاً إياها بأنها “دولة مهمة” و”ثاني أقوى دولة في العالم”، منوّهاً إلى أن دمشق لا ترغب بمغادرة موسكو “بالطريقة التي يتمناها البعض”، حيث أشار الشرع إلى أن استمرار التعاون معها يخدم المصالح الاستراتيجية لسوريا، مع التأكيد على أولوية المصالح السورية دون إثارة صراعات مع الدول الخارجية.
ففي الوقت الذي تسعى فيه حكومة دمشق الناشئة لبناء شرعيتها الدولية، وهي حاجة ضرورية لبناء الدولة وإعادة تنشيط الاقتصاد، فإنها بحاجة لعلاقات إيجابية مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، لا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بما يمكّن من استخدام هذه العلاقة كورقة مساومة في مواجهة الولايات المتحدة والقوى الغربية، بحال رفضت إضفاء الشرعية على هذه الحكومة. ومع مسألة الشرعية، تسعى هذه الحكومة لموازنة علاقاتها الإقليمية والدولية لضمان عدم عودة سوريا كساحة للتنافس والصراع الإقليمي والدولي.
هذا إلى جانب قدرة روسيا المحتملة/المأمولة بإعادة الأموال السورية المنهوبة من قبل رجالات النظام البائد، والأهم، إحضار الرئيس السوري المخلوع إلى منصة العدالة التي يأملها السوريون، والتي ستمنح الشعبية لأي حكومة تستطيع القيام بذلك. وقد تكون موسكو أعدّت لهذا الأمر، من خلال منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء الإنساني، وهو ما يمكّن من مقاضاته على أراضيها. على عكس اللجوء السياسي الذي يمنع تسليم حائزه، وهو ما تم التطرّق إليه عموماً خلال مفاوضات الجانبين، من خلال نقاشهما لقضية العدالة الانتقالية، وإبداء موسكو النية للمساعدة في هذا المجال، بجانب استعدادها للقيام بدور بارز في إعادة الإعمار، مع ترحيب/دعوة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لزيارة موسكو، بما يوحي بوجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات على أسس من التعاون والتفاهم والمصلحة المشتركة، تتخطى إشكالية الماضي القريب.
مع ذلك، وبالنظر لحرص الإدارة السورية الجديدة على كسب ثقة ودعم الغرب، فإنها ستحرص على تنظيم أي علاقة أو تعاون مع روسيا ضمن حدود لا تؤدي إلى نتائج عكسية على هدفها المذكور، وعلى ذلك، قد تتفاوض مع موسكو على اتفاق يمنح الأخيرة وجوداً محدوداً على الساحل السوري، وضمن شروط مختلفة تماماً عما جرى سابقاً، بجانب تقليص الوجود العسكري الروسي ضمن حدود الدفاع عن النفس، مع بقاء قواعدها في سوريا كمرافق لوجستية بدون أي مكونات عسكرية نشطة، بحيث يمكن استخدام هذا الوجود المحدود كضمان لتحقيق التوازن السياسي خلال المرحلة الانتقالية المقبلة. وعلى المدى المنظور، ستعمد موسكو لممارسة سياسة “الترقب والانتظار” لإعادة تثقيل دورها في الساحة السورية، وخلاله، ستبقى سوريا مهمة، لكنها لن تكون عنصراً ذا أولوية في استراتيجية روسيا الشرق أوسطية في الوقت الحالي.
رصيف 22
———————————
التنميط وخطاب الكراهية في سوريا… إرث الحرب والصراع/ جعفر مشهدية
الخميس 6 فبراير 2025
تُعَرِّف استراتيجيةُ الأمم المتحدة خطابَ الكراهية بأنه “أيُّ نوع من التواصل الشفهي، أو الكتابي، أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدراء أو تمييز، إشارةً إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، والتي يقصد بها الدين، أو الانتماء الاثني، أو الجنسية، أو العرق، أو اللون، أو النسب، أو النوع الاجتماعي، أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية”.
ولا يوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فما يزال هذا المفهوم محلّ نزاع واسع، وخاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدم التمييز، والمساواة. لكن الأمم المتحدة وضعت هذا التعريف لتوفير إطار عمل موحّد لمعالجة القضية على الصعيد العالمي.
“شكلو متل النازحين”
وبالحديث عن الحالة السورية، نجد أن تطور خطاب الكراهية وأسلوب التنميط بين أفراد المجتمع مرّ بثلاث مراحل؛ الأولى قبل اندلاع الثورة السورية، والثانية جاءت خلال سنوات العسكرة، والثالثة بعد سقوط نظام البعث. كل ذلك كان يجري على أعين فكر البعث وأيديولوجيته التي استفادت من هذا الخطاب في السيطرة على البلاد.
سنسأل أنفسنا سؤالًا هنا: من منا لم ينعت الآخر بصفات وعبارات تعزّز الانقسامات الداخلية حتى لو على سبيل الدعابة؟ ألم نسمع أحدهم يقول في وصف شخص، ربما يبدو مختلف الهيئة، “شكلو متل النازحين”، بالإشارة إلى أهل الجولان الذين نزحوا قسراً بعد نكسة حزيران 1967؟ أو من يقول “عزيمة شامية” (إشارة إلى أن أبناء الشام يتسمون بالبخل)؟
لقد قسمنا أنفسنا بتصوراتنا عن الآخر دون أن ندري، فالكل يعتقد، اعتقادًا غير منصف، بأن معظم الدمشقيين يحيون على مبدأ “اللي بيتجوز أمي بقلو عمي”، والحلبي “هواه تركي”، وأولاد الساحل “أزلام السلطة”، وأهل إدلب وريف دمشق “متعصّبون”، وغير ذلك من التنميط الذي لا ينسجم والواقع، ويطلق أحكاماً بشكل أحمق ومرفوض على مكونات وفئات اجتماعية عديدة.
ومع انفجار الوضع السوري، أصبحت الخانة وقيد الهوية دليلاً على الانتماء السياسي أو الديني، فصارت الهوية التي كتب عليها طرطوس أو اللاذقية دلالة على أن صاحبها “شبيح” حكماً، ومن أفراد الطائفة العلوية بلا شك، وأصبح حاملو الهويات التي كتب عليها جوبر، أو داريا، أو حريتان، أو الزبداني، أو حارم، في ظن البعض، “متشدّدين – إرهابيين”، وإن كان صاحب الهوية من القامشلي فهو “انفصالي”، وأهل السويداء يرتبطون بالسياسي اللبناني وليد جنبلاط أكثر من ارتباطهم بوطنهم، ولديهم علاقات جيدة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأفراد الطائفة الشيعية “أتباع إيران”، والمسيحيون “أتباع فرنسا”.
“شبيحة” و”فلول النظام”
وفي المرحلة التي تلت سقوط نظام بشار الأسد، تغيرت صيغ خطاب الكراهية لكنها حافظت على وجودها العلني والمباشر، وأُضيف إليها فكرة التعميم، فعلى سبيل المثال، نُعت العلويون والشيعة بـ “الشبيحة” أو “فلول نظام” الذين يجب أن تتم محاسبتهم. تناسى أصحاب هذا الخطاب أن نظام الأسد كان متعدّداً في أركان فساده وإجرامه، غير أن هذه المكوّنات، كغيرها من النسيج المجتمعي السوري، تمتلك شريحة معارضة للنظام السابق، وتعرضت للإهمال والتنكيل.
وهنا نرى أننا من دون أن ندري، نخر خطاب الكراهية والتنميط حياتنا اليومية، فبتنا نسمعه في بيوتنا وشوارعنا وأماكن عملنا، وحتى في مدارسنا.
يقول الناشط المدني “حسين شبلي”: “بعد الاستقلال، لم يكن هناك خطاب كراهية بالمفهوم المتداول اليوم، بل بعض التنميط الواضح والتعميم للتصرفات الفردية على المجموع، فاستغلت قراءة البعث الواقع السوري للاستفادة من التنميط وصراع الهويات لتأمين استمرار الوجود في السلطة”.
واتصالاً بما سبق، يتابع “شبلي” أنه “مع انفجار الوضع السوري دخلنا بأزمة مصطلحات، كالحريات والأقليات والأكثريات، وبدأنا نتقاذفها وفق تصورات فردية، ما زاد من التنميط ورفع منسوب خطاب الكراهية من الأطراف جميعها، وهنا نجد أن معارضة الأسد سقطت في فخّ فكر البعث الهوياتي الذي يعتمد على شيطنة المناوئ له ووسمه بالانفصال والطائفية والإرهاب، فأصبحت المعارضة تُغذي خطابًا مشابهًا ضد من يخالفها بالرأي ولو بمفردات ومصطلحات مختلفة، ولم تتجه لخطاب مواطنة جامع يعالج المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية”.
والدلالة على كل ذلك وفق “شبلي” هو استمرار التنميط وخطاب الكراهية بعد سقوط نظام الأسد بالتزامن مع غياب القانون الضابط والحراك السياسي الواعي وتعاظم الهمروجات الفيسبوكية التي ربما تأخذنا جميعاً، في حال استمرارها، لإعادة الاقتتال أو التقسيم.
وفي سبيل إنهاء الحلول، يعتبر “شبلي” أن “أول خطوة على طريق الحل تكون في تقييم ما جرى ومعرفة سبب وصولنا لهذه النقطة من تاريخ البلاد، وتهذيب المجتمع على فهم الآخر، والاقتناع بأن للآخر مُطلق الحرية بممارسة ما يريد بشكل لا يضر غيره، والبحث عن تعريف جديد للهوية السورية دون استقطاب أو محسوبية أو تعميم، وكل ذلك يقوم على مبدأ المواطنة المطلقة لا المقنعة بسرديات التعايش المشترك”.
“إذا شفت الأعمى طبو”
بدورها، أرجعت المحامية والناشطة شروق أبو زيدان، خطاب الكراهية والتنميط ضمن المجتمع السوري لفترات قديمة: “ما نتحدث عنه موجود منذ وقت طويل، وكان يتجلى بالكثير من المظاهر، فمنها ما يتم تداوله على سبيل الدعابة أو المثل الشعبي (إذا شفت الأعمى طبو مانك أكرم من ربو)، (متل الشوايا)، (عقل كردي)… إلخ، وقد تم العمل على هذا الخطاب من مختلف الجهات لتعزيز الانقسامات حتى لو لم يكن بشكل مباشر، ولكن عدم العمل على خفض هذا الخطاب وإلغائه، والتوجّه لبعض الفئات أو المكونات بالدعم واستثناء الآخرين من ذلك عزّز فكرة الانقسام”.
تقول: “في الحروب والثورات وفي غياب الرؤية الوطنية والهوية الجامعة (وهي أكثر ما لعب به النظام البائد واستثمر) يعود الناس للهويات البسيطة ما قبل الدولة، ما يعزّز الانقسامات وخطابات الكراهية المختلفة التي تبدأ بدعابة وتنتهي بانفصال أو حرب أهلية، فمجرّد تقسيم الشعب السوري لمذاهب وطوائف ومناطق يكفي لتعزيز الكراهية والانقسام، حيث بات الشمال انفصالياً، والجنوب حليفاً للأعداء، وطائفة ما كلها توسم بوسم متنفذيها، وأخرى تنسب لدولة لأنها أقلية أو لديها مظلومية ما، وهذا وسّع الشروخات، وجعل الأكثرية من السوريين/ات يحتمون وراء مذاهبهم خوفاً من الآخر الذي يتم وسمه بمختلف الوسوم”.
وتضيف في حديثها لرصيف22، أن واقع التنميط وخطاب الكراهية أصبح أسوأ بعد سقوط النظام، “فمعاقبة طائفة كاملة لأن رؤوس النظام ينتمون لها يكفي ليثبت كم تجذّر هذا الخطاب ليصبح جزءاً من ذواتنا وتفكيرنا وتصنيفنا لبعضنا البعض، ومحاولة إثبات مجموعات من مناطق أخرى أو فئات أخرى أنهم وطنيون وسوريون، مؤشر على أنهم يخشون من نظرة الآخرين لهم والتي عزّزها هذا الخطاب طوال سنوات الحرب”.
وفي سياق متصل، توضح المحامية أنه “عندما تتعزّز فكرة الاختلاف السلبي والشعور بعدم الانتماء للكل، يصبح الأمر معتاداً، وننظر لهذا الآخر المختلف على أنه عدو لنا، أو على الأقل ليس صديقاً، ويصبح الخلاص الفردي غاية. وفي حالتنا؛ قد يكون هذا متجسّداً بشكل طوائف، ومناطق، ومكونات، ومجموعة مظلوميات، نحاول الحصول على تعويض لها من الآخرين الذين سببوها أو لم يمنعوها على الأقل”.
وعن طرق التخلص من هذا الخطاب والنجاة من انفجاراته، ترى أبو زيدان أن “قبول الآخر وقبول الاختلاف، وعدم التمييز بالحقوق، والعمل بالقوانين المراعية لحقوق الإنسان، والعودة للحديث باسم سوريا، وتفعيل الحوار العابر للمناطق والمكونات على جميع المستويات، وعدم إقصاء أي طرف، وتطبيق العدالة الانتقالية، وتعزيز دور المجتمع المدني. كل هذا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين ليصبح واقعاً ملموساً”.
لا مفر من التعددية
وبعيداً عن القراءة الحقوقية والمدنية، تشرح الاختصاصية الاجتماعية غُدران نجم، في حديثها لرصيف22، أن “الأسرة والمجتمع المحلي الصغير يمكن أن يكونا عاملين رئيسيين في تعويم خطاب الكراهية والصور النمطية، فإذا كانت الأسرة تتبنى صوراً نمطية أو خطاب كراهية تجاه مكوّن معين، فمن المرجّح أن يتأثر الأفراد بذلك، والمجتمع القريب أيضاً، بما في ذلك المدرسة والجيران والأصدقاء، ما يؤدي إلى تكوين تصورات جمعية قد تكون مليئة بالتحيزات والصور النمطية”.
وتضيف أن “في البيئات المشحونة بالكراهية هناك صعوبة للتحرّر من القوالب الجاهزة دون جهد ووعي ذاتي، خاصة إذا كان الشخص لا يملك تجارب واقعية حقيقية مع الآخر، بمعنى أنه كلما كانت التجربة قوية وعميقة كان من الممكن أن تؤثر وتكسر الصورة النمطية”.
وعن أماكن الإصلاح، تقول: “الحلول تبدأ من المدرسة، وفيها يتم التركيز على غرس قيم التفكير النقدي، والتعددية، والاحترام المتبادل، وتقبل الآخر والقبول به منذ الطفولة الأولى، وللإعلام دور محوري في تقديم صورة عادلة ومتوازنة عن جميع فئات المجتمع، بعيداً عن التحيزات والأحكام المسبقة”.
يذكر أن الحرب أثّرت بشكل كبير على شخصية السوري بسبب تداعياتها العسكرية والاقتصادية، لكن الأساس في إعادة بناء الشخصية السورية يقوم على إعادة إنتاج المجتمع وتخليصه من كل السلبيات التي ورثها على مدار عقود، حتى تحولت إلى مثل شعبي أو طرفة يتم تداولها بقصد المزاح، وما بين هذا وذاك، تترسّخ انقسامات تظهر عند الانفجار، أو تساهم في الوصول إليه دون قصد، ولا سبيل إلى الخلاص إلا بتشكيل هوية وطنية جامعة مانعة قائمة على الحوار والتسامح.
رصيف 22
———————————-
=======================




