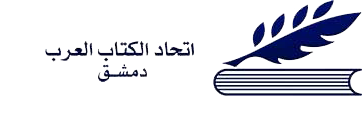ترجماتٌ صارت أصلاً/ عباس بيضون

23 فبراير 2025
حين نُلقي نظرة على تاريخ الترجمة في التراث العربي، يفاجئنا أن نعرف أنَّ “كليلة ودمنة” هو الكتاب الأول الذي يُشتهر بأنّه مُترجَم، رغم أنَّ الأصل الفارسي غير موجود. هذا الكتاب ترجمه أشهر الكتّاب في زمنه، ابن المقفع، الذي وُلِد في العام السادس من القرن الثاني لظهور الإسلام.
كان التدوين في بداياته حين تمّت الترجمة، التي اعتبرت، في حينها، رائعة النثر العربي. لم تمنع وصمة الترجمة من أن يبني النثر العربي عليها، وأن يعتبرها حلقةً أساسية في تاريخه. شاع أنّ الكتاب مُترجم، ولسنا نعلم كيفية الترجمة وتضاعيفها، لكن ما نلحظه فوراً، وربّما بسببه، أن نثر “كليلة ودمنة” مختلف عن نَصّ القرآن. لا نجد في الكتاب ما يردّنا إلى النثر القرآني.
في البداية لا نلحظ أنّ الكتاب يتوخّى السجع، ولا نلحظ فيه الغناء الذي يسبّبه. ذهب القرآن إلى إنكار شعريته، فمحمد ليس شاعراً والقرآن ليس شعراً. هذا الإنكار يُلقي ظلّاً على الأسلوب القرآني، إذ إنَّ القرب من الشعر أمرٌ لا ينفيه، بل يلتفّ عليه بالإنكار. نثر ابن المقفع الذي يعود إلى ترجمة جديدة على النثر العربي، بل هو مقابل النثر الأُمّ، الذي هو نثر القرآن، مختلف. هذا ما يدعو إلى التأمّل. كيف أمكن في قرن واحد تجديد النثر، أو النزوع إلى أسلوب آخر فيه. هل “كليلة ودمنة” مُترجم حقاً؟ وهل استطاع رجل واحد، بفضل لغة ثانية، أن يَنفذ بهذه السرعة إلى أسلوبٍ آخر خاص، ويُطعّم اللغة العربية بأثر لغةٍ أُخرى؟ لا نملك جواباً، لكنّنا نقف عند تجديد ابن المقفع، ولا يمكننا أن نبتعد عن نسبته إلى الترجمة.
في كلّ حال، إن نثر ابن المقفع هو غير نثر القرآن، وغير نثر سجع الكُهّان، الذي يُزعم أنه سبق الإسلام. إنه نثر آخر، وسيسير على نهجه الخاص، ومعارضته للقرآن. ناثرو العرب الكبار، الجاحظ على سبيل المثال، الذي لا يترجم، لكن في تضاعيف كتاباته إشارات إلى أقوام آخرين، لهُم لغاتهم التي فعلت في العرب، ولبست كتاباتهم أو استمدّت منها. أسلوب الجاحظ الفاتن أسلوب ليس قرآنياً هو الآخر، هل نستنتج من ذلك أن أثر اللغات الأُخرى استمرّ في الأدب العربي، وأن الاختلاط اللغوي، وربّما الترجمة، ظلَّ يلعب فيه. لا ننسى بالطبع أنّ النّصّ القرآني يتّسع لروايات موجودة في الأصول الإنجيلية والتوراتية، وأنّ الاختلاط اللغوي هو هكذا نتيجة مباشرة لتمازج الديني والثقافي واللغوي في الأخير.
لا نعرف واقعات أُخرى بحجم واقعة “كليلة ودمنة”، لكن بالتأكيد لم يكن هذا التمازج بعيداً عن مراحل أُخرى. لا بدّ أنّه كان، على سبيل المثال، في أصل الموشّحات الأندلسية، وذلك الأدب المُختلط لغوياً الذي عرفته الأندلس، كما لا بدّ أنه كان في أصل محطّات أُخرى كالمحطة المملوكية. لكنّ الواقعة الأشهر، والتي تستوقفنا طويلاً، هي “ألف ليلة وليلة”، التي في أصلها نثر مختلف على نحو هائل، لا عن النثر القرآني فحسب، بل عن الإرث الأدبي بكامله. من هنا يمكن الحديث عن كتابة أُخرى، هي هذه المرّة قريبة من الحَكْي، كما أنها، في صراحتها وجسارتها على الموضوع الجنسي، تُواصل إرثها الشعبي واستمدادها من الشارع. أي تُواصل بُعداً عن فصاحة قد يكون من أثر الترجمة.
الشائع أن “ألف ليلة وليلة” مترجمة. ليست مترجمة فحسب، إنها لغة السُّوق، لغة المدينة، وفوق ذلك هي الشفوية والمحكية. ما يستوقف هنا، هو ذلك اللجوء إلى الترجمة، لإيجاد نصوص حُرّة في موضوعها ولغتها وأسلوبها. لا نعرف تماماً الدافع وراء ذلك، هل هو احترام اللغة الأُمّ والحرص على عدم هلهلتها؟ هل هو احترام للأدب واعتباره فوق العادي والمبتذل والمحسوس؟ هل يعني ذلك أنّه ليس من حقّ أحد أن يلعب باللغة، وأن يطلق خيالاً إلى أبعد ما يجوز، وأن يحوّل القصة لعبة والأدب تسلية؟
مرّة جديدة يتحرّر النّصّ في لغةٍ مُستعارة، ولا يبقى له أي واجبٍ أخلاقيٍّ، بل لا يعود في موازاة الأخلاق ويفتقر إلى أي هدف. يبدو هنا أنّ الترجمة هي السبيل لرفع أي التزام عن كاهل النّصّ، وتحريره من أي اعتبار ديني. هكذا يبدو النّصّ المُترجَم بعيداً جدّاً عن النص القرآني، بل بعيداً جدّاً عن القالب الأدبي. ليس له احترام وهذا يبدو من إرساله على سجيّته، من تسفيله إلى حدّ استظهاره لما يقع في الأسفل.
حركة الترجمة هذه لا تطاول الشعر. لا بدَّ أنَّ المترجمين استشعروا صعوبة ترجمة الشعر، لكنّهم احتجّوا بأنه ليست هناك حاجة لشِعر الآخرين، فالعرب أُمّة شاعرة والعرب آباء الشعر وأهله، ولن يضيف لهم شعر الآخرين شيئاً. كانوا يعتدّون بشعرهم، رغم أن كتابهم الأُمّ القرآن “نثر”. الأرجح أن نثرية القرآن لم تكن بعيدة عن الشعر، يُمكن القول إن القرآن ليس شعراً، كما أنه ليس نثراً، إنه في مرتبة ثالثة، بل هو فيها أكثر اتّساقاً مع الشعر، وأكثر إلهاماً له.
يُمكننا أن نفهم من ذلك أنه مع إنكاره لكونه شعراً، ومع نقده للشعر في آيات معروفة، لم يحمل على عداوةِ الشعر، ولم يواجهه أو يطوّقه أو يُلزمه. طبعاً كان هناك من يتحرّجون من الشعر، ومن ينأون بأنفسهم عنه، هؤلاء أتقياء متشدّدون، لكن الشعر بقي متصلاً، ورغم أنّ الدين والمناسبات الدينية صارت بين موضوعاته، إلا أنّه لم يغدُ دينياً، بل يمكن القول إنه كان في معارضة دارجة للدين. نحن هكذا لا نجد للشعر العربي القديم نفساً روحانياً، بل إن الصوفية، على سبيل المثال، لم تكن بين أولياته.
الشعر الصوفي مثلاً لم يغلب عليه، وإذا شئنا أن نجد عناوين لهذا الشعر، فإن دنيويّته أبرز، بحيث ترجّح وثنيته أو بداوته. صارت الخمريات على سبيل المثال بين أكبر أغراضه، كذلك الغلمانيات، وحفل ذلك بمعارضة صريحة للتعليم الديني. يمكننا هكذا أن نجد في الخمريات دنيا أُخرى وديناً آخر. كما يُمكننا أن نشعر أنّ الشعر يُعارض الدين أو يغدو مقابلاً له، وأنه؛ والمديح بين أركانه، يدخل في صلب الدولة، وبقدر ما تعارض هذه الدين أو تكوّن ديناً لها، يذهب الشعر هذا المذهب ويدخل في الخليط الديني الدنيوي.
لن نُتابع التسلسل التاريخي. سنصل فوراً إلى بدايات القرن العشرين، وما مُهّد له في القرن الذي سبق. سنجد أنّ الشعر بدأ يشعر بحرَجٍ لُغويّ، كان أمام خليطٍ موروثٍ حسب أنّه تنازلات متسلّسلة، لذا كان، في وجه منه، يرتدّ إلى فصاحة ماضية، لكن هذه كانت متصلة بأحداث ومناسبات راهنة. كان يُساير وضعاً ساده استعمارٌ غربيٌّ في الغالب. لقد ورث لغة في غير أيّامها، وبدت فصاحتها وقوّتها، بالقياس إلى الماضي البعيد، نوعاً من أجنبية.
في المقابل وجد شعراء، على رأسهم المهجَريون، أنفسهم أمام لغة، تخليها عن فصاحتها يردّها هي الأُخرى أجنبيّة أُخرى. كنّا حيال ترجمة من مصدرين وذات وجهين، لكنّ الشعر، من هنا وهناك، كان يدلّ بأجنبية جعلتها غريبة في لغته، وإن بدا ذلك غير واضح تماماً.
كان لا بُدَّ لحركة الشعر الحديث، في أواسط القرن العشرين، أن ترثَ هذا التغرُّب، وأن تُحاول الالتفاف عليه. كان هذا الإرث فصاحة غريبة وركاكة غريبة هي الأُخرى. لم يكن الشعر بعيداً عن ترجمة مباشرة، كورناي لدى أحمد شوقي وبودلير لدى إلياس أبو شبكة. في هذين وغيرهما شعراء الرومنطيقية الفرنسية، وربّما فاليري بعده. كانت هذه ترجمة واعية مقصودة. لم تكُن فقط تمثُّلاً وإعادة قراءة وإنشاء مباشراً في لغتنا بحيث نصنع منها ما يوازيهم. لقد تسرّبوا غالباً بمقاصدهم الكبرى وعناوينهم، وتركوا مقابلهم مسحات وظلالاً.
لم يكن هذا فعل الترجمة بكامله. لقد انتظرت حتى بدايات وأواسط القرن العشرين لتحقّق غزواً عاصفاً لشعرنا. نتذكّر هنا “مجلة شعر” التي قامت على الترجمة، ونقلت إلى العربية شعراء من كلّ البلاد، بعضهم لم يكن وصل إلى قمّته، أوكتافيو باث مثلاً. كانت الترجمة التي ركّزت على الأحدث والسُّرياليّين بوجه خاص، عبارة عن شعر هؤلاء بكلمات عربية، لقد كانوا بذلك نماذج قريبة، فهُم بمقاصدهم، ولكن أيضاً بكلماتهم، صنعوا شيئاً في لغتنا.
بدا الشعر من ذلك الحين يحاول مثيلاً لذلك ونظيراً. كان بوعي، أو بلا وعي محاولة لإعادتهم في لغتنا، وبشروطها ومبانيها ونظامها، لم تعد العناوين ولا المقاصد كافية، صار العمل في اللغة وعلى اللغة. كان زرع شاعر أو أسلوب في العربية، أو كتابة ما يوازي عموماً شعرياً وارداً من الفرنسية أو الإنكليزية، كان هذا العموم يصل إلى النَّص المُطلق شاملاً حصيلة هذه القراءة متعددة الأسماء واللغات. من الممكن أن يكون الشعر كلّه في حوزتنا، وعلينا أن نكتب كما هو الشعر وكما وصل إلينا.
الترجمات هذه لم تكن غريبة بل صارت أحياناً الأصلَ. قصائدنا التي نكتبها كنّا نعرضها على هذا النَّصّ الشامل. عربيّتها كانت ترجيعاً وتوقيعاً وإنشاءً في مقابلة هذا النّصّ وبالرجوع إليه. ما رسخ منه في نفوسنا صار معياراً ومرجعاً. لقد لعبها الشعراء داخل اللغة وعلى اللغة، بحيث صارت مقاصدهم من بعيد قريبة من الترجمة، وصار العمل الشعري نفسه لوناً من الترجمة أو تعميقاً لها. هذا ما كان يحدث من وراء الترجمات، لكن لا يمنع أن بعض الترجمات صارت أصلاً، بل واستحالت مراجع للشعر. يمكننا أن نقول ذلك عن ترجمة أدونيس لسان جون بيرس، التي هي جزء من مؤلفه الشعري. لقد حققت هذه الترجمة نموذجاً حافلاً استتبع مبنى ونبراً في الشعر، بل قام عليه تيار كامل من الشعر، وصار حدثاً في شعرنا، لقد جرى هكذا زرع بيرس في لغتنا، أو إنجاز بيرس عربي.
* شاعر وروائي من لبنان
العربي الجديد