البياض في سياق سوري/ نائلة منصور
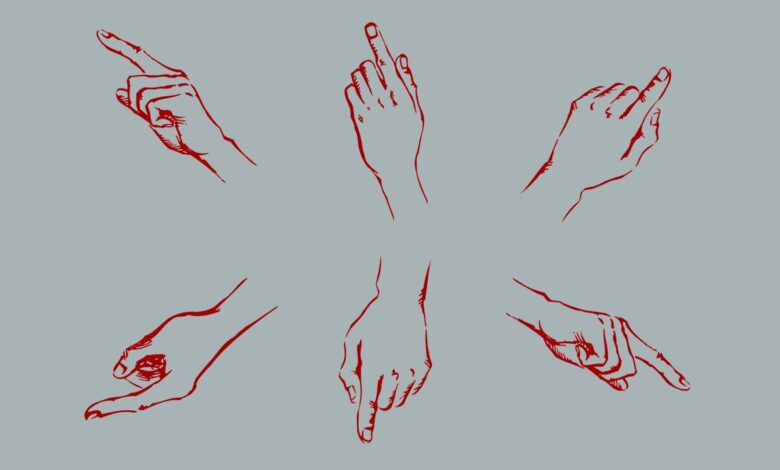
تكثر حالياً بين السوريين النقاشات والندوات حول ماهية الوطنية السورية، أو العناصر الحاملة لمشترك جمعي سوري ممكن، بعد أن كثرت قبل ذلك، ومنذ بداية الثورة عام 2011، التعابير والمفاهيم الدالّة على تقسيمات لا نهائية، شهدنا خلال تداولها طفرات سريعة في دلالات كثير من التعابير.
على سبيل المثال، بعد أن كانت كلمة «أقلوي» تشير للمنحبس في عزلة ضمن بيئته الأهلية، الأقلية، في هلع دائم من أي دينامية جديدة تُحرّك الفضاء العام وتُهدّد استقرار وأمن عائلته وجماعته، ومكتسباته الاجتماعية بوصفها أعطية من النظام، أصبحت تُستخدم للدلالة على كل من هو من منبت عائلي ينتمي لواحدة من الأقليات، بغض النظر عن مدى انعزاليته وهلعه أو عدمه.
في جملة ما استُخدم كذلك من دالّات، هناك تعبير «السوريين البيض». من المغري استعادة وتفكيك هذا التعبير ودلالاته المُعاشة بدقة. قد يكون أصل المصطلح السياق التركي القريب والذي قسّم الأتراك إلى بيض مدينيين كماليين وسود ريفيين، الأولون لديهم مشاعر طبقية وعنصرية تجاه الأخيرين وسهولة نحو الميل الإقصائي الإبادي، ولكن يبقى أن التعبير استُعير، على سبيل القياس، من تعبير «الرجل الأبيض»، أي من الدراسات العرقية النقدية ومن الدراسات التابعية وما بعد الكولونيالية، وعلى العموم من الكتابات عن تجربة الاستعمارية وتجربة العبودية، فيبدو منطقياً أن نستعير أداة قراءة من هذه الدراسات ونقارن البياض المدروس في هذه الدراسات بالبياض السوري. والحقيقة أن المقارنة بين أشياء متباعدة جداً تبدو مثمرة أحياناً بسبب التباعد على وجه التحديد وليس بسبب التقارب. التباعد في التجربة يُبرز أوجهاً جديدة لأشياء مألوفة يعمى عنها المرء. اخترت لهذا نصاً لسارة أحمد، المنظرة الباكستانية الأميركية، حول البياض، يحمل عنوان ظواهرية البياض، تستعيد فيه أفكار كثيرة من فرانتز فانون وكتابه بشرة سوداء أقنعة بيضاء، وتحاول أن توصّف تجربة الجسد الملوَّن، الأسود؛ التجربة الحسية في الموروث المكاني المحيط، والموروث المؤسساتي الذي هو فضاء أبيض أصبح لامرئياً لكثرة اعتياديته، حيث المرئي الوحيد غير الاعتيادي فيه هو الأسود.
سورياً، حين استُخدم التعبير بدايةً على ما أذكر، استُخدم قبْل كل شيء للدلالة على السوريين ذوي النوازع المتقبّلة للفاشية ضد عموم المنتفضين السوريين، والمتماهين بصعوبة مع فكرة الانتفاض التحرّري وآلام وعذاب السوريين المعارضين، واستُخدم للدلالة على أنماط استهلاك حداثية قريبة من استهلاك غربي، ليست متّسقة بالضرورة مع أي قيمة حداثية أو كونية إنسانية، لأشخاص كانوا قريبين نوعاً ما من السلطة، ومن دائرة فساد – مباشرة أو غير مباشرة – تيسّر لهم أموراً كثيرة. واستُخدمت كذلك للإشارة للمشتغلين في منظمات المجتمع المدني غير الأهلية، الإنجيؤوزية بمعنى آخر. وعلينا ألا ننسى أن أكثر من استخدمها في فترة من الفترات، حتى وإن شملوا أنفسهم ضمن البيض من باب النزاهة،1 هم شابات وشبان درسوا في جامعات غير سورية، واطلعوا على تيارات ودراسات ما بعد كولونيالية.
ولكن الملفت هو توالد الدلالات ليصبح الأبيض السوري دالّاً على حقائق مُعاشة كثيرة، الموحَّد بينها غير واضح. في ميدان وسائل التواصل الاجتماعي الصغير، المتعلق بحلقتي الصغيرة، قرأت أن السوري الأبيض، بعد أن لام ضحايا البراميل على أخطائهم، أخذ يتّهم عبد الباسط الساروت ورفاقه على أسلمة الثورة. الأبيض كذلك هو صاحب «القيم المختلفة» عن قيم الشباب من الأطراف والهوامش، الذين لا يتّسقون مع شكل معياري لتداول الشأن العام بالنسبة له. هناك أيضاً لاجئون بيض، يحاولون التبرؤ من سلوكيات ونقائص لاجئين سوريين آخرين متواجدين معهم في أوروبا. وهناك سوريون بيض يحثّون على تحديد النسل في المخيمات، مما ينبئ عن ميل تصنيفي واستعلائي لعموم السوريين الذين لا يتوقفون عن الإنجاب رغم ظروف المخيمات، وهو ميل قابل ليصبح فاشياً واستئصالياً بسهولة. هناك كذلك ميل لاعتبار العلمانيين تنويريين صلدين، بالضرورة، لا يرون في الإسلام قوة ومكوناً ثقافياً له دور سياسي وتغييري، وبالتالي هم بيض.
من هو الأبيض إذاً، نسبة للملوَّن المعرقَن (racized) في سوريا؟
هل هو صاحب الثروة أو الاقتدار المالي، أو الرأسمال الرمزي والاجتماعي، والمؤيد لسحق السوريين أو غير المكترث بسحقهم؟ ليس تماماً. هناك مصفوفة أكثر تحديداً، فإن كان غير المكترث أقرب لشكل «أصيل» متخيَّل عن الهوية السورية، سيصعب وصفه بالأبيض السوري بسهولة. الأبيض السوري «براني» بمعنى ما، ليس «أبراتب» أو «أبمحمد» المألوف. إن تاجراً مدينياً مقتدراً أو متوسط الاقتدار، عربياً سنّياً، غير مكترث بالبراميل المرماة على رؤوس الناس، سيصعب إلصاقه بالبياض العنصري. وللمفارقة، لا بد لنا أن نذكر هنا أن أبناء بعض المدن يعتبرون أنفسهم معرقَنين مضطهَدين، اندثرت هويتهم الأصلانية أو أصبحت بمثابة الخلّ الوفي، أسطورة غير واقعية بفعل هجوم البيض (بمعنى السلطة هذه المرة) من الريف.
هل السوري الأبيض هو سليل عائلات عريقة وأعيان، محايد – أو ليس معادياً للنظام – ولا يكترث بالسوريين المسحوقين في المعتقلات والمحاصرين؟ ليس تماماً. يمكن أن يكون أبيض في حال ابتعد عن هوية ومظهر و نمط استهلاكي «أصيل»، ولكن على العموم، يحصّنه الإرث العائلي نوعاً ما إن لم يرتبط مباشرة بالعصابة الحاكمة سياسياً أو اقتصادياً.
هل هو «الأقلوي»، المنتمي لمنبت من الأقليات الدينية او الطائفية أو العرقية بتعريفنا المعياري، نسبة لأغلبية سنيّة عربية؟ ليس تماماً. هناك تمايزات كذلك بين الأقليات. والأكراد لا يُلقَّبون بسهولة بالبيض. حتى العلويون المؤيدون لا يُلقَّب الفقراء منهم بالبيض.
هل هي المرأة النسوية؟ النسوية على العموم لصيقة بالبياض، وغير المحجبة «بيضاء حتى تثبت العكس» وفق تعبير صديق. النسوية المعادية للنظام عتبة تماهيها مع النظام أكبر من أبراتب وأبمحمد المؤيدين، وهي بالتالي بيضاء، أما المذكوران فقد يهديهما الله يوماً، وإلى حينها لن ننعتهما بالبيض. في مقال ضمن ملف أعدته الجمهورية عن العمل الحزبي والنضالي، كتبت ليلى العودات توصيفاً دقيقاً لمعضلة من تمثل المرأة السورية في المحافل الدولية أفضل «تمثيل» يعبر عن الهوية السورية. بكل الأحوال، إن أردنا أن نقارب بأي طريقة كانت ثنائية أبيض/معرقن لتجربة الأجساد السورية، فستكون الثنائية الكبرى الأوضح هي رجل/امرأة، وبعدها تأتي كل الطبقات وتلاوينها في الأجساد الأخرى.
هل الجغرافيا تغير ثنائية سوري أبيض/سوري أسود؟ سيُضاف إلى كل الهرميات والطبقات السابقة في مصفوفة الأبيض نوع الجواز وقوته في هرمية الجوازات المتيحة لحاملها دخول عدد أكبر من الدول دون استصدار فيزا. طبعاً، تحصيل الجواز يعني مجمل أشياء في مصفوفة حامله، إن لم يكن
هناك الأدوات والمؤهلات العلمية وإتقان اللغات الأجنبية، التي تعني تعليماً أفضل وشبكات علاقات أتاحت الأدوات اللازمة والعمل وما إلى ذلك. هناك الكثير من النخب السورية خارج البلد، ممن يحرصون على فرز السوريين أخلاقياً وسياسياً إلى بيض وأقل بياضاً، يبدو تشدُّدهم أحياناً في تمجيد النموذج الأصلاني «اللي يشبهنا» وكأنه ضرب من تناذرات عقدة الناجي، وإلا فما تفسير أن المتعلم المقيم في ألمانيا، والذي لا يمكن أن يحجّب ابنته، يستهجن استغراب العلمانيين تحجيب طفلة في عمر الرابعة؟
لدينا الفيز وجوازات السفر، ولهذا المبحث مكان آخر يطول الخوض فيه هنا، ولكن في هرم التمايزات العالي، في طبقة ما من الهرم، هناك من كان يسهل عليهم التنقل بسهولة متى شاؤوا خارج سوريا، ولم يشعروا للحظة أن أبواب سوريا ستُغلَق عنهم إلى الأبد. كان – وما زال – لديهم أطواق نجاة عديدة إن اضطُروا للخروج، وكان يمكنهم أن يبقوا في بلدهم. لهؤلاء أيضاً بيضهم وسودهم وفرزهم الخاص بهم.
في النهاية وكما تبلورت مدلولاتها عبر التداول، استعارة الأبيض تعني: مبتعد أو متعالٍ عن شكل أصلاني متخيَّل عن الهوية السورية، متعالٍ عن نضال المسحوقين من السوريين، ينحو إلى أنماط حياة واستهلاك معينة. الأبيض ببعض السياقات هو بكل بساطة «آخر» إذاً، خاصة أن الأصلانية شديدة التنوع في بلادنا بحسب متغيرات كثيرة. بالمقابل لم يتم استعارة تعريفات للجسد المعرقَن الملوَّن، من هو السوري الأسود بالضبط؟ كانت استعارة الأبيض مجردة تماماً، لا ترتبط أبدً بالسياق الأول العبودي والعرقي للكلمة. بعض مُطلقي الأحكام حول السوريين البيض، يرفضون في الوقت نفسه اعتبار السوريين غير بيض، أو القول بوجود مسألة طبقية في سوريا، ومنهم من يساند ترامب في أميركا، مثلاً.
لن أزعم أني قادرة (أنا أو غيري) على نفض الغبار عن المكنون الثمين للهوية السورية. هناك تجارب سورية مشتركة وليس بالضرورة قيم مشتركة. لكني أشعر أن استبطان هذا المفهوم الاستعاري فيه إجحاف وعدم دقة، أولاً اجحاف لتاريخ من التمييز ضد أصحاب البشرة الداكنة حقيقة، لجماعات سوداء صغيرة وجدت في بلادنا وعاشت فعلاً مُعاش الجسد الأسود المعزول والمهَّمش ضمن جماعات أقل سواداً، ولتاريخ عبّرت عنه مخيِّلة جمعية ومدونات ونصوص ترفع من شأن صاحب البشرة البيضاء مقابل أسود البشرة. إلا أن الأهم ليس التاريخ هذا، الأهم هو أن تطبيع هذا المصطلح، كاستعارة من سياقات أخرى، هو إزاحة النقاش عن كنه العصابة الحاكمة التي تفرض على الأجساد كلها – بدرجات متفاوتة حسب التمايزات الاجتماعية، وتمايزات العصبوية والقرب من مركز السلطة الفساد، وتمايزات الجندر – تفرض معاش الجسد الأسود في محيط أبيض. لا يوجد سوري أبيض. هناك نظام وحشي ومجرمون بدرجات متفرقة، بين إجرام مباشر وبين عماء أخلاقي عن السلطة الحاكمة.
لشرح معاش الجسد الأبيض في «بحر البياض»، تناقش سارة أحمد مقولتين هما «التوجه» و«العادات والمؤسسات». التوجه بمعنى أنه حين يتعين على الجسد الأبيض التوجه في المكان، سينطلق وينظر بمنظور معين، بدءاً مما اعتاد أن يلمسه: طاولة المكتب ونافذة غرفة المكتب، ثم يدرك ما وراءه من غرفة جلوس وغرفة أطفال وأولاد وكل شي. توجهه محكوم بإرث من التموضعات الثابتة و«المريحة»، بمعنى أنها تكرار وتكرار أجيال من البيض. كل شيء أبيض فلا يعود البياض مرئياً بهذا المعنى. حين يكون كل شيء أبيض أو صمم للبيض عبر أجيال يصبح لا-شيء. البياض لا-لون.
بَيْدَ أن مسار الجسد الأسود هو مسار واعٍ، مُرهَق بسبب درجة وعيه من قبل صاحبه. يتصور فانون وتنقل سارة أحمد مشهد رجل أسود يرغب بالتدخين، وهو جالس إلى مكتبه تحت عين الرجل الأبيض، ستنتقل يده اليمنى لطرف الطاولة لتناول السجائر، ويده الأخرى إلى جيب القميص لتناول القداحة، وستكون كل لحظة في هذا المسار مُدرِكة وتتطلب جهداً. بحسب فانون، هناك جلد جواني أسود غير مرئي، هو تاريخ الجسد والأجساد التي أورثته لون بشرته الجواني.
تاريخ الأجساد هو ما تتطرق له أحمد في نقاشها الثاني حول المؤسسات والمعاش فيها. المؤسسات والإدارات هي أول أشكال تنظيم العمل في المجتمعات، وقد صُمِّمت تاريخياً للبيض، فتنساب فيها الأجساد البيضاء براحة، وتمتد طرائق التوظيف فيها للأجساد البيضاء، فيأخذ المكان أشكال وحركات البيض المتكررة عبر الزمن، ويصبح الجسد الأسود مرئياً جداً حال دخوله مكان الاجتماعات مثلاً، أو لا-مرئياً إن صار أبيض، فيتصرف ويتحرك وينتمي للمؤسسة مثل الرجل الأبيض.
التوظيف مصمَّم بشكل يصعب للجسد الملوَّن اجتيازه، وإن اجتازه فسيكون من المفروض عليه إتقان وتملُّك كل طقوس وإشارات الـ«نحن»؛ النحن البيضاء طبعاً، كنوع من الأنا العليا. والتوظيف هو بشكل ما تهذيب للأجساد لتنضوي في بحر البياض. في بعض اللحظات، يصبح التواجد في نفس المكان «المنسجم» غريباً. هذا التقارب بين الأجساد ضمن المؤسسة، مؤسسة العمل مثلاً، يُفلت لحظات غريبة أو عدم راحة؛ اللحظة التي ترف فيها عين الجسد الأسود بقوة ليعاود النظر. هذه اللحظة غير المنسجمة تخلق اضطراباً لصاحبها، وغالباً ما تكون لحظة سياسية.
تقدّم القدرة على سكنى الجسد الآخر، الجسد الأبيض، وكأنها وعد بصعود اجتماعي. يأتي الفرد إلى هذا العالم مع تاريخ ومصادر وإرث. هذه العناصر التاريخية عند الفرد قد تكون رافعة أكثر استطاعة، تساعده على أن يسكن الجسد الأبيض، وتُضاف إلى رأسمال الفرد. ومع ذلك، لا ينبغي أن يُعتبر هذا الجسد الأبيض مضموناً إلى الأبد. قد يشكك في لحظة ما ببياض الفرد فينهار كل عالمه، يفقد حركيته، أي قدرته على التحرك ضمن البحر الأبيض.
بسحب هذه الصور الحسيّة للأجساد باتجاه فضاء السوري السياسي، فكل الأجساد ملونة وكل الأجساد بيضاء، بحسب الموقع في المجتمع والعلاقة مع السلطة والعلاقة مع الإرث والمصادر الذاتية العائلية، وبحسب متغيرات الانتماء الأخرى، وبحسب قربه أو بعده من مركز سلطة ما، وبما يمارسه من سلطة على غيره. المركز «الأبيض» هو الحكم الأسدي. المتحرك في موجة «بيضاء» مريحة هي مزرعته، يتملك كل مفاصلها، أي سوريا. والمعترض هو الأسود المرئي جداً الذي تجب إزالته.
1. هناك نص آخر لسارة أحمد ملفت في هذا السياق يحمل عنوان إعلان البياض: عن اللاأدائية في مناهضة العنصرية، تحكي فيه على إمكانيات إعادة إنتاج الامتيازات والقمع في اللحظة التي يعلن فيها الأبيض أنه أبيض وواع لامتيازاته في إطار مناهضة العنصرية، يصبح النضال واتخاذ الموقف الإطار الذي يسكنه الأبيض براحة كبيرة، كما اعتاد أن يتملك الأمكنة والمنابر براحة. تصبح مناهضة العنصرية وزناً جديداً يضاف إلى ميزان امتيازاته. مع التحفظ على هذه النزعة المتطرفة التي تشلّ أي كامن كوني في النضال المناهض للعنصرية، أجد أن المقارنة سديدة جداً هنا: في بداية الاحتجاج السوري كانت الناشطات الشابات والشباب الذين استخدموا التعبير، كنوع من الإقرار أو الوعي ربما بامتيازاتهم، يكادون لا يزيدون شيئاً على المستوى الأدائي، أي على مستوى محاربة، لنقل، العنصرية، أو البياض الفاشي السوري، اللهم إلا إضافة مقولات معرفية مثقلة لرأسمالهم المكتسب. وفق هذه اللوحة، قد يكون السوري المعرقَن هو من لا يعرف متى وكيف تُستخدم كلمة «أبيض» وهو الذي لا يعرف بأنه معرقن.
موقع الجمهورية




