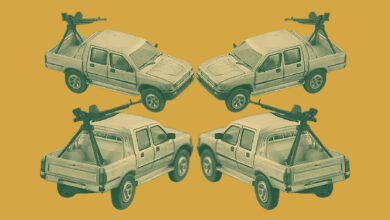الوجه السياسي للثقافة.. ردًا على حسام الدين درويش

رد هيئة تحرير مجلة قلمون على التقرير النقدي الذي نشره حسام الدين درويش في صفحات موقع مركز حرمون بتاريخ 9/ 3/ 2021
المحتويات
أولًا: بين الذاتية والموضوعية
ثانيًا: هل “المواقف” غير علمية بالضرورة؟
ثالثًا: في لعبة التفسيرات المختلفة للظاهرة الواحدة
رابعًا: في مأزق النقد الذاتي والانتقائي
خامسًا: حول التوظيف السياسي للدين في سورية
سادسًا: لا تناقض بين الخبرات الشخصية والبحث العلمي
سابعًا: التوصيات العلمية للبحوث
ثامنًا: هل التوثيق حاجة علمية أم وسواس؟
تاسعًا: حول التوثيق واللغة وعلامات الترقيم
خاتمة
يقدم التقرير النقدي الذي نشره حسام الدين درويش، في موقع مركز حرمون للدراسات المعاصرة، تقييمًا عامًا وشاملًا لأعداد مجلة قلمون منذ صدورها، مع تركيز على العدد الأخير “التفاعل بين الدين والمجتمع في سورية 1920- 2020“. ومن الواضح أن درويش قرأ ملف العدد الأخير، وقدم عددًا كبيرًا من الملاحظات حول المنهجية والتوثيق ومضمون العدد، معرفيًا ومعياريًا. يشيد التقرير النقدي بإيجابيات المجلة وإنجازاتها، مثلما تفرد القسم الأكبر والأساس لما يظن أنه “سلبيات” أو “أوجه نقص” أو “عدم حياد معرفي” أو “انزلاق وراء الجانب الأيديولوجي على حساب الجانب المعرفي والمنهجي” وقعت فيه المجلة في عددها الأخير.
وعلى الرغم من أن بعض انتقادات كاتب التقرير النقدي كانت محقة، وأن بعض البحوث يحتاج بالفعل إلى تدقيق أكثر، غير أن ما يلفت الانتباه في النقد الذي يقدمه هذا التقرير هو التركيز على مفهوم قديم نسبيًا للعلوم الإنسانية يريد أن يجعلها مجرد علوم تقلد الموضوعية المطلقة الموجودة في العلوم الطبيعية. وهذه نظرة لم تعد موجودة في الجامعات المعاصرة، لأن الإنسان بكل بساطة ليس مجرد حجر أو أخشاب، حتى إن المفكرين غالبيتهم في العالم اليوم يريدون أن تقود العلوم الإنسانية العالم، لاعتقادهم أن هذه العلوم هي التي عليها مساعدة هذا العالم للوصول إلى عالم أكثر إنسانية وعدالة.
فالتقرير النقدي أخذ على المجلة عدم الفصل الدقيق بين الثقافة والسياسة، وبين الجانب الوصفي للبحوث والجانب المعياري، وبين العناصر الذاتية والعناصر الموضوعية، وبين المعرفة والأيديولوجيا، علمًا بأن العلوم الإنسانية المعاصرة انتهت إلى قضية يعرفها المجتمع العلمي جيدًا، وهي تتعلق بعدم وجود حدود فاصلة ودقيقة بين الثقافة والسياسة، وبين الوصفي والمعياري، وبين الذاتي والموضوعي، حيث يصعب على أي باحث اليوم الادعاء بأن بحثه وصفي وموضوعي بصورة كاملة، أو أنه متحرر تحررًا كليًا من المؤثرات المعيارية والذاتية. فالمهمة التي يريد كاتب التقرير النقدي أن تقوم بها مجلة قلمون ليست مهمة طوباوية لا واقعية فحسب، بل مهمة لا علمية أيضًا، وهذا أمر مستغرب.
سنناقش بالتفصيل هذه القضايا، وقضايا أخرى غيرها، ونبين تهافتها. فالثقافي قد ينقلب في أي لحظة إلى سياسي، والبحث الموضوعي لا يمكنه أن يتحرر من العناصر الذاتية، مثلما أن القضايا الوصفية يمكن أن تتضمن في الوقت نفسه عناصر معيارية.
أولًا: بين الذاتية والموضوعية
يقول كاتب التقرير النقدي في إطار توجيهه نقدًا للمجلة، من حيث عدم التزامها بالحدود الفاصلة بين الجانب الوصفي والجانب المعياري: “ينبغي لأي بحثٍ معرفيٍّ أن يتأسس على ما هو وصفيٌّ، ومستقلٌّ، جزئيًّا ونسبيًّا، قدر المستطاع، عما هو معياريٌّ وتقييميٌّ. فمثلًا، عند الحديث عن ظاهرةٍ ما، ينبغي الانطلاق من فهمٍ أو تعريفٍ أو مفهومٍ وصفيٍّ وتحليليٍّ لتلك الظاهرة، بغض النظر عن موقفنا العقائدي/ السياسي/ الأيديولوجي منها. ولا يبدو أن هذا ما يحصل في بعض نصوص مجلة قلمون وملفها المذكور. ويبدو ذلك واضحًا في “كلمة العدد”، وفي عددٍ من النصوص التي يتضمنها ذلك العدد” (ص 5).[1] أما أهم مثال يسوقه درويش على عدم التزام بحوث المجلة بتعريفات وصفية معرفية مستقلة عن الجانب المعياري والقيمي، فهو مفهوم “الحداثة” الذي استخدم في أكثر من بحث. ملاحظة درويش الأساس أن مفهوم الحداثة استُخدم في المجلة للقول بأن حقوق النساء والرجال متساوية، وأن الناس يحق لهم التعبير عن أنفسهم بحرية، والدفاع عن حقهم في صنع حياتهم الخاصة، وعلى الجميع أن يحترم حقوق الآخرين (ص4).
غير أن التقرير النقدي يعد أن هذه الأوصاف للحداثة معيارية، وأن بحوث المجلة تتبنى “أيديولوجيا حداثوية لا ترى في الحداثة إلا ما هو إيجابيٌّ .. (الحداثة) التي يبدو أن لا خلاص ولا حول ولا قوة إلا بها. فالحداثة، هنا، مفهومٌ معياريٌّ، وأحاديٌّ في معياريته، بالدرجة الأولى، وهو مختزلٌ في مجموعةٍ من السمات والقيم والأفكار الإيجابية المرغوبة. لكن، هل هذا ما يمكن وما ينبغي للباحث أن يقتصر على رؤيته في هذا السياق. لقد تعرضت الحداثة إلى نقدٍ شديدٍ، حتى من قبل عددٍ كبيرٍ من الحداثويين المتبنين لها والمدافعين عنها، في حين أن تلك الرؤية المعيارية الأحادية تختزل حقيقة الحداثة أو “الحداثة الحقيقية” في منظورٍ سياسيٍّ/ أيديولوجيٍّ/ ذاتيٍّ، بعيدًا عن الرؤية المعرفية الموضوعية المتوازنة الضرورية”. (ص5).
يمكن الرد بسهولة على هذا الخلط بين الوصفي والمعياري، لأن تبني المجلة قيمَ الحداثة المرغوبة في شعوب العالم كلها، لما حققته هذه الحداثة من حياة عادلة وكريمة، أمر لا يدخل في إطار الرؤية الأحادية المعيارية بل مبني على قاعدة استقرائية علمية. الحداثة تجربة حققت نجاحًا كبيرًا لعدد كبير من شعوب العالم، ولذلك يمكن أن تكون قاعدة للحياة المستقبلية للسوريين، هذه هي القضية بكل بساطة.
إذا كان مفهوم الحداثة يقوم على مجموعة من القيم، وهي الديمقراطية، العلمانية، المساواة، حقوق الإنسان، المواطنة؛ فإنه يمكن أن نجادل بأنه لا يوجد تعريف وصفي للحداثة متحرر تمامًا من المعيارية، ولا يمكن الاعتقاد بوجود مثل هذا الإنسان على وجه البسيطة الذي يستطيع تعريف الحداثة من دون اختزالها في “مجموعةٍ من السمات والقيم والأفكار الإيجابية” اختزالًا واعيًا أو غير واع، ولذلك يمكن مطالبة كاتب التقرير النقدي بالاستشهاد بتعريفات وصفية للحداثة خالية من أي عناصر معيارية، تعريفات تتصف بـ “الرؤية المعرفية الموضوعية المتوازنة الضرورية” -على حد زعم كاتب التقرير النقدي- ولا سيما أن العلوم الإنسانية المعاصرة ترى أن الحكم على أمر ما بأنه موضوعي هو حكم ذاتي في النهاية، وصادر عن شخص له رغبات وعنده معارف وخبرات، ويهدف للتأثير في أوضاع معينة، حتى فكرة “الموضوعية ” هناك من يرى أنها ابتُكِرت لإيهام البشر أنفسهم بأن ثمة شيئًا أسمى من الذاتية.
في المعرفة التي تتناول موضوعات سياسية وثقافية تتحول “المعرفة” إلى أداة للصراع، وكشف للأوهام، والحصول على حقوق، والدفاع عن مبادئ، ولذلك يغدو الحديث عن الفصل بين الوصفي والمعياري في المعرفة السياسية حديثًا أيديولوجيًا، ورغبات مثالية خالية من الحس بالمسؤولية العلمية.
من حيث المبدأ، يمكن لأي باحث في العالم أن يصف أي بحث علمي آخر بأنه يقع تحت تأثير مؤثرات ذاتية أو معيارية. ونكاد نجزم بأنه لا يوجد أي مفكر أو فيلسوف وُجِّه له نقد ما، إلا كانت المعيارية أحد العناصر النقدية الحاضرة، وهذا لسبب بسيط، وهو أنه لا توجد موضوعية منزهة من المعيارية، ولذلك يستسهل الجميع هذا النقد، ويرددونه كقوالب جاهزة منذ مئات السنين. فالباحث إذا اختار وضع فرضية معينة لبحثه، واستبعد فرضيات أخريات، فإنه يختار بصورة ذاتية، ونتيجة لتقديراته الذاتية بوصفه خبيرًا في مجاله التخصصي، ولديه تراكمات معرفية يرى أنها ذات أهمية، وإذا اختار منهجًا معينًا للقضية التي يدرسها، وفضّله على منهج آخر، فهذا التفضيل أيضًا ذاتي، وإذا تبنى تعريفًا لمفهوم، وفضله على تعريف آخر، فإنه ينظر لهذا التفضيل على أنه تفضيل ذاتي. وعلى ذلك، فإن النقد المتعارف عليه في مجال بحوث العلوم الإنسانية لا يعنى بما إذا كان البحث موضوعيًا أم ذاتيًا -فهي تهمة يمكن توجيهها إلى الجميع- النقد المتعارف عليه يتناول عادة مدى اتساق البحث مع نفسه، أو يشغل بما إذا كانت النتائج التي توصل إليها الباحث سليمة ومبنية على مقدمات البحث ومجرياته. أو يهتم بمدى تحقيق الباحث الأهدافَ التي وضعها لبحثه، أو تقديمه بالفعل مبررات مقنعة تدعم ما يريد قوله.
أما النقد الذي تتعرض له الحداثة (والذي طالب التقرير النقدي بأن تأخذه مجلة قلمون بالحسبان) فليس المقصود به رفض الحداثة أو رفض قيمها، كما توهم درويش، فالنقد الذي تعرضت الحداثة له -وما زالت- فقط بقصد تحسين السبل لتحقيق قيمها على أكمل وجه، وتدارك جوانب النقص. فعملية الحداثة مستمرة منذ أكثر من قرنين من الزمن، وهي تتعرض من حين لآخر لإعادة تقييم بقصد تحقيق المساواة بين البشر بصورة أفضل مما هي عليه في الواقع، أو للوصل إلى أعلى درجات المساواة بين المواطنين في الحقوق، أو لمنح كامل الحقوق للفئات التي ما زالت تحتاج إلى دعم، أو لجعل حياة البشر أكثر رفاهًا وسلامًا وحرية، وعلى ذلك ما زالت الحداثة هي القاعدة العريضة للحياة السياسية في البلدان المتقدمة عالميًا، أي عملية تاريخية وسياسية وثقافية ومعرفية متكاملة، وتناولها بهذه الصورة لا يحولها إلى مجرد منظور ذاتي أو معياري أو انحياز أيديولوجي.
النقد الذي تتعرض له الحداثة أمر لا يعني السوريين كثيرًا (لم ينتبه كاتب التقرير النقدي لهذا الأمر)، لأن النقد عادة يرافق التجارب لتعديل التطبيقات وتحسينها، بينما لم يبدأ السوريون بعد بعملية دخول عالم الحداثة بالأصل، وهم يعملون من أجل هذا الدخول، ودفعوا ثمنًا باهظًا من أجل ذلك، وما زالوا يدفعون. يمكن للفرنسيين -مثلًا- أن يستفيدوا من نقد الحداثة الذي قدمه (آلان تورين)، ومفاده أنه يجب إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورًا أكبر من الدور الحالي. أو يمكن للكنديين أن يستفيدوا من نقد (تشارلز تايلر) للحداثة، ومفاده أنه لا بد من إعطاء الحقوق الثقافية للأقليات بالتوازي مع إعطاء الحقوق السياسية.
أما في الحالة السورية فما الذي يمكن أن يستفيده السوريون من نقد الحداثة؟ يمكن للذي بنى بيتًا كبيرًا وأثثه على أكمل وجه أن يستفيد من نقد حول لون الأبواب أو سعة المطبخ، ونحو ذلك، أما الجار الذي لم يتمكن من الحصول حتى على أرض يبني عليها بيته، وهناك من يحاربه ويمنعه من الحصول على هذه الأرض، بل يطلق عليه النار لمحض أنه يقترب منها، فإن النقد الذي يقول له بأن مطبخ الجار ليس واسعًا، وأن عليه أن يأخذ ذلك بالحسبان عندما يبني بيته، إذا استطاع ذلك؛ يغدو نقدًا خاليًا من المعنى، وقد يثير سخرية مرة في نفس هذا الشخص الذي لم يتمكن من الحصول على قطعة الأرض أصلًا. الطلب من بحوث المجلة بأن تأخذ النقد الذي يوجه للحداثة في العالم الغربي اليوم، عندما تتناول تلك البحوث السوريين وأوجاعهم، يريد من المجلة أن تسقط مشاغل أوروبا اليوم على معاناة السوريين، وهذا غبن ما بعده غبن بحق السوريين الذين لديهم طموح مشترك مع الأوروبيين من أجل بناء دولة المواطنة والقانون، ولكن لديهم أوضاع ومصاعب ومشكلات مختلفة اختلافًا كليًا عن تلك الموجودة في أوروبا.
إن العلوم الإنسانية (السياسة، علم الاجتماع، الفلسفة، علم اجتماع الأديان، علم النفس الاجتماعي..) في النهاية محض أجوبة ومقاربات لمشكلات مجتمع معين، ولا معنى لها خارج هذا الإطار وهذا هو سبب نشأتها أصلًا. وهذا هو وضعها في أوروبا. أما في سورية فإن النظام الأسدي على مدى نحو نصف قرن منع نشوء علوم إنسانية سورية (على غرار علم الاجتماع الفرنسي أو الألماني مثلًا) لأنه لا يريد لهذه العلوم أن تفضح الأوهام التي يفرضها على السوريين، والتزييف الذي يمارسه في السياسة والاجتماع، وحيلته المفضلة في تخويف السوريين بعضهم من بعض، مثلما لا يريد كشف التفافه على الديمقراطية عن طريق العلمانية، وتذويبه السوريين في القومية بقصد إلغاء وجودهم الفعلي.
أما في ما يتعلق بالفرق بين الحداثة وما بعد الحداثة، ومناقشة أوجه النقد الذي وجه للحداثة، في سياق تطور المجتمعات الغربية، فهناك عشرات الكتب التي تناقش موضوعات كهذه، تباع منذ أكثر من أربعين عامًا “تحت جسر الرئيس بدمشق”، لأنها كتب لا تزعج النظام الأسدي في شيء، ما دامت لا تقترب من سورية والسوريين وتفضح استبداد المستبدين بهم.
إن المهمة الأساس التي أخذتها مجلة قلمون على عاتقها منذ تأسيسها الإسهامُ في التأسيس لعلوم إنسانية سورية، تعالج وتناقش وتحلل أوضاع سورية والسوريين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة. تفكر في طوائف السوريين وإثنياتهم وأيديولوجياتهم وأرزاقهم وثقافتهم وأحزابهم وسجونهم وريفهم وحواضرهم وأدبهم وفنونهم. ولعل العدد الأخير الذي ناقش قضية تفاعل الدين والسياسة في سورية يعد من أهم الخطوات التي قطعت في سبل التأسيس لتلك العلوم.
في هذا السياق، فإن بعض بحوث المجلة فضلت أن تقوم بوصف المفهومات التي تتحدث عنها، ولكن هناك بحوث تعتقد أن هناك اتفاقًا على مضمون المفهومات، وأن تعريفها لا يضيف شيئًا جديدًا للبحث. والطريقتان متبعتان في المناهج العلمية المعاصرة. فمثلًا إذا عدنا إلى مفهوم الحداثة، ليس من الضروري إعادة تعريفه في كل موضع يرد فيه، لأن هناك معنى عامًا مستقرًا في ذهن علماء الاجتماع جميعهم عن الحداثة، من حيث هي قيم تقوم على حقوق الإنسان والمساواة والحريات والمواطنة والعلمانية. ولذلك لا يوجد حداثات، كما يعتقد كاتب التقرير النقدي، بل هناك حداثة واحدة، وكل من لا يقبل بتلك القيم يخرج من مفهوم الحداثة. ولكن ضمن مسار الحداثة التطبيقي في مختلف البلدان قد تحصل اجتهادات وتغيرات في أساليب التطبيق، ولكن ذلك لا يمس بـ “البنية الصلبة” التي تكوّن مفهوم الحداثة. وعلى ذلك لا يستقيم أن نقول مثلًا إن هناك حداثة ترفض حقوق الإنسان، أو لا تقبل بالعلمانية، ولذلك لا يمكن الحديث عن حداثات. وما ينطبق على الحداثة ينطبق على العلمانية؛ فالعلمانية واحدة في العالم الغربي، وبنيتها الصلبة واضحة، ولا توجد علمانيات، كما توهم درويش، فالأحزاب ونُظُم الحكم أما أن تكون علمانية أو لا تكون، وكون النظام الأسدي طبق نسخة مشوهة من العلمانية، وفرق بينها وبين الديمقراطية، لا يجعلنا نقول إن العلمانية علمانيات. العلمانية في تركيا وفرنسا وأميركا والسويد واليابان واحدة، هناك اختلافات في التطبيقات هنا أو هناك، مثلًا فرنسا لا تريد للطالبات أن يلبسن الحجاب، ولكن السويد ودول أخرى تقبل بذلك، ولكن هذا الخلاف لا يمس بجوهر العلمانية من حيث هي إبعاد سلطة ممثلي الأديان عن السياسة بمجالاتها كلها، وحيادية الدولة تجاه الأديان. في السويد وفرنسا يقرر البرلمان فقط في مسألة الحجاب، وهذا هو جوهر العلمانية من حيث إن السلطة للشعب، وليست لرجال الدين. تفتيت العلمانية إلى علمانيات، والحداثة إلى حداثات، والإسلام السياسي إلى إسلامات، عملية تربك البحوث العلمية وتحولها إلى بحوث غارقة في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، بقصد تمييع الموضوع أو الادعاء بالتعالي العلمي، أو نقل وجهة البحث من سورية والسوريين إلى مشاغل نظرية تتعلق بالفرنسيين والألمان وغيرهما. ترغب مجلة قلمون بمناقشة العلمانية في سورية، والإسلام السياسي في سورية، وإلى أي مدى يحتاج السوريون إلى الحداثة، وغير معنية بكيفية تطبيق العلمانية في بريطانيا مثلًا، لأن بريطانيا ليست سورية، ومستوى تطورها، ومشاغلها، يختلف عما هو عليه في سورية.
في النهاية، فإن الموضوعية موضوعيات، وليست موضوعية واحدة، وهي تختلف بحسب المنظور الفلسفي لكل مفكر. والتعريفات الوصفية صيغة من صيغ الموضوعية لا أكثر، ولا يمكن اتهام بحث باللاموضوعية لأنه لا يستخدم طريقة تعريفات المصطلحات وصفيًا. هناك مئات التعريفات للحداثة، وأكثر من 100 تعريف للثقافة في الفكر العالمي، غير أنه لا يمكن القول بأن هذا التعريف أكثر موضوعية من ذاك. نرغب بالمجادلة أكثر لنقول إن الأيديولوجية قد تكون الدافع الرئيس لاختيار تعريفات معينة للمفهومات، مثلما يمكن أن تكون الحافز الأساس للوصول إلى نتائج معينة لبحث مبني بناءً معرفيًا/ وصفيًا دقيقًا.
وما نريد أن نقوله في نهاية مناقشة قضية العلاقة بين الموضوعية والذاتية، أو بين الأحكام الوصفية والمعيارية أنه على الرغم من محاولة كاتب التقرير النقدي تجميل انتقاداته غير الموضوعية بقوله “ربما أفضى هذا المنظور أو (آلية) تطبيقنا له، في هذه الدراسة، إلى تقديم نظرة وانطباعات غير متوازنة عن المجلة، بسبب ما يبدو أنه زيادة التركيز على السلبيات، وعدم التركيز، بالقدر نفسه، على الإيجابيات. ونحن نود تصحيح تلك النظرة والانطباعات المفترضة، والتشديد على أن المجلة تضم عددا من الأبحاث المهمة، بل والرائدة في مجالها، وأن تلك البحوث لا تستحق القراءة فحسب، بل وتستحق أن تكون موضع نقاش وأساسا لبناء ترا كم معرفيين” (ص 44)، لكنه لا يخبرنا أي الأبحاث تلك حازت على الجدارة، وهنا أيضًا يناقض نفسه في مستويين، فهذا القول لا يتّسق مع تعميم السلبيات (لا مجرد التركيز عليها) الذي مارسه على طول الخط من جهة، ومن جهة ثانية كيف توصّل إلى هذه الإشادة ببعض الأبحاث، مع تأكيده أن تقريره النقدي “لم يتضمن أي تقييم كامل لأي بحث من بحوث الملف”؟!
ثم يعود كاتب التقرير ليقول: “يظهر أنّ المرونة المعرفية التي تتحلى بها المجلة شديدة وزائدة عن الحد” (ص47)، لكنه لا يخبرنا ما هي “معايير المرونة المعرفية” التي يراها، والتي تقبلها المجلة وتنشرها، وما هو هذا “الحد الأدنى المعرفي” الذي يجب أن يرتفع، ولأي درجة. أليست هذه الأحكام “أحكامًا معيارية جازمة “على المجلة وأبحاثها ودرجة المعرفة وحدودها فيها؟
ولتقييم ونقد أي مقولة أو فكرة أو خلاصة في مواد المجلة، لا تتوافق مع مسطرته الأيديولوجية أو المفاهيمية أو انحيازاته الفكرية، يكتفي درويش باتهامها بـ “هشاشة موقفها المعرفي أمام أي تحليل مفهومي، أو قراءة تاريخية، للظاهرة المدروسة”(ص7)، وكأنّ الجملة محقة لمجرّد أنه ينطق بها. وكذلك حين يرفض كل طرح لا يعجبه، بزعم أنه “يفتقر إلى ما يسوّغه معرفيا”. ألا يبدو هذا النوع من الرفض والتقييم المتعسّف مفتقرًا إلى ما “يسوّغه معرفيًا”، ما دام أنه اعترف في خاتمة تقريره النقدي أن دراسته هو نفسه “عاجزة بالتأكيد عن أن تتناول بالتحليل والنقد والتقييم، أو حتى بالوصف فقط، كل ما جاء في الملف. ولم تتضمن الدارسة أي تقييم كامل لأي بحث من بحوث الملف، واكتفت بمناقشة ما جاء فيها، “مناقشة عامة”، من جهة، ومناقشة منظورية من جهة أخرى” (ص 46)؟.
ثم إن مجلة قلمون لا تهدف إلى تبني نزعة “أكاديمية” شكلانية، تعكس ضربًا من التقيّد الحروفي والهيام بالمصطلحات التي يريدها درويش مضبوطة بطريقة حديدية. ويبدو أنّ المعرفة عنده شرح مصطلحات ومفاهيم وإنتاج مزيد من المصطلحات والمفاهيم، على ما يظهر في (ص 9) حين يخبرنا عن غاية المعرفة والبحث لديه: “فما هو مطلوب هو التمييز المفاهيمي، إظهار التمايزات.. التي يمكن أن توجد، من حيث المبدأ.” وقد طلب ذلك من كل بحث يمر على مفهوم هنا أو مصطلح هناك، ولو كان المفهوم ثانويًا وليس رئيسًا في البحث.
ثانيًا: هل “المواقف” غير علمية بالضرورة؟
يعيب كاتب التقرير النقدي على المجلة أن لها رسالة وشخصية ثقافية/ سياسية تتبناها منذ عددها الأول. وتقوم شخصية المجلة ورسالتها على أن قضية السوريين وكفاحهم لنيل حريتهم وإقامة مجتمع مبني على المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان قضية أساسية للمجلة. أما وسيلتها لتحقيق ذلك فتقوم على استخدام الثقافية وسيلة للتأثير في السياسة، ولذلك تتبنى المجلة البحوث التي تحقق هذه الشخصية، وتستخدم مختلف نظريات العلوم الإنسانية المعاصرة ومناهجها، للقيام بتحليلاتها ومناقشاتها للوضع السوري. غير أن كاتب التقرير النقدي يظن أن هذه الرسالة خطرة، وقد تطيح بالأساس العلمي للبحوث، وتخلط الأيديولوجيا بالمعرفة، والثقافة بالسياسة. مثلما يمكن أن تؤدي إلى انزلاق المجلة -كما يرى التقرير النقدي- في “التقابل بين قطبين مانويين، ندافع عن أحدهما أو ندعو إليه ونشيد به، من جهةٍ، ونرفض القطب الآخر أو نهاجمه أو ننتقده ونبين سلبياته، من جهةٍ أخرى” (ص3). وأن ذلك “من العلامات أو القرائن القوية الدالة على وجود الفكر الأيديولوجي” في المجلة (ص3). أما مشكلة مثل هذه السياسة للمجلة أنها ترفع “الرايات الأيديولوجية التي ترى في طرفٍ ما (المشكلة)، وفيما يناقض ذلك الطرف (الحل)، بدون وجود تدرجٍ أو منطقةٍ وسطى ما بين الجنة/ النور والجهنم/ النار” (ص10).
غير أن مجلة قلمون ترى أن اتخاذ المرء موقفًا سياسيًا من قضية ما لا يعني بالضرورة أن موقفه لامعرفي أو غير علمي، أو يريد إقصاء الآخر بالضرورة. علماء العلوم الإنسانية وأساتذة الجامعات المرموقة في العالم جميعهم لهم مواقف سياسية واضحة تجاه قضايا العصر. حتى جائزة نوبل المعروفة تعطى في بعض الأحيان لأسباب سياسية، وهي صادرة من واحدة من أرقى الاكاديميات في العالم، كما أن طه حسين فُصل من الجامعة لأسباب سياسية على بحوث كتبها بأعلى درجات الدقة العلمية، والأمثلة هنا بالمئات وليست، بالعشرات.
النقد الذي وجهه كاتب التقرير النقدي للمجلة بوجود “تأثيرٍ سلبيٍّ للسياسة/ الأيديولوجيا في الثقافة/ المعرفة”. (ص9)، هو ذاته نقد غير علمي، لأن العلوم المعاصرة لا ترى هذا التأثير السلبي إلا في حال أن الباحث لم يلتزم بالروح العلمية في بحثه. الروح العلمية والدقة المنهجية هما قاعدتان أساسيتان للبحوث المنشورة في مجلة قلمون، أما وجود تراخٍ علمي في نقطة ما من بحث ما، فهو أمر قد يحدث في بعض البحوث، ولكنها قضايا لا تجرح علمية البحوث. والباحثون في العالم ليسوا جميعًا على السوية نفسه والنشاط العلمي ذاته. كما أن اهتمام بعض البحوث، ومنها كلمة العدد، بالجانب السياسي للموضوعات التي يتم تحليلها، لا يعني بالضرورة نيلًا من الجانب المعرفي، بل يعني صبّ الاهتمام على الرسالة السياسية التي تؤديها المجلة عن طريق المعرفة والثقافة.
يضاف إلى ذلك أن بحوث المجلة لا تتخذ موقفًا أحاديًا “مانويًا”، كما يحلو لكاتب التقرير النقدي أن يردد. بحوث المجلة حللت الوضع الاجتماعي والسياسي في سورية، وكشفت الأطراف التي تتلاعب بالدين والطوائف والمذاهب لخدمة مصالح استبدادية، سواء أتى هذا الاستبداد من النظام السوري أم من بعض الرموز الدينية والثقافية، مثلما كشفت آليات عمل أولئك المستبدين، وشبكة التأثيرات الخفية التي يمارسونها. وهي بذلك تعتقد أنها تساعد السوريين في فهم أنفسهم وأوضاعهم الدينية بطريقة فضلى. وعلى ذلك، فإن النظر في بعض الأطراف على أنها “شريرة”، لأن هذه الأطراف لا ترى أي مستقبل لها إلا عبر إقصاء السوريين والنيل من حقوقهم؛ مشكلة تلك الأطراف، وليست مشكلة المجلة، ولذلك فإن أولئك الأشرار هم الذين عليهم أن يتحملوا تبعات مواقفهم، ولا يتعلق الأمر بنظرة أحادية من قبل المجلة. على النقيض، فإن المجلة منهمكة إلى أقصى درجة بفضح أولئك المستبدين أمام الشعب السوري عن طريق العلوم الإنسانية.
يمكن المجادلة بأن كل من لا يقبل بقاعدة الحداثة، ويعادي قيمها القائمة على حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والحريات هو آخر و”شرير”، لا بالنسبة إلى مجلة قلمون -كما توهم كاتب التقرير النقدي- بل بالنسبة إلى مستقبل السوريين الذي تفكر فيه المجلة. ولذلك فإن تعريته، وتوضيح مكامن قوته، والأوضاع التي يوظفها لخدمة نفسه، وشبكة العلاقات الخفية التي يبنيها، يقع في صلب رسالة المجلة. وعلى هذا، فإن التدرج أو المنطقة الوسطى التي تحدث عنهما درويش تقليد شعبي، وليست تقليدًا علميًا، يُعبَر عنه في الثقافة الشعبية السورية بـ “تبويس الشوارب”، وهي طريقة تقفز على أي حال فوق المشكلات، وقد تفتح باب التنازلات والمساومات.
ثالثًا: في لعبة التفسيرات المختلفة للظاهرة الواحدة
يمارس كاتب التقرير النقدي مع بحوث مجلة قلمون لعبة تشبه لعبة النصوص التي تمارسها المدارس الإسلامية المختلفة في الفقه حتى يومنا هذا. وتقوم هذه اللعبة على أن كل من يريد أن يقدم تفسيرًا ما أو رأيًا فقهيًا أو شرعيًا معينًا يعود إلى النصوص الأساسية في الدين الإسلامي، ويختار ما يشاء من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، ويخضعها لتأويله الخاص بحيث تنسجم مع وجهة نظره، مع تجاهله الآيات التي لا تتناسب مع موقفه الفقهي الذي يريد فرضه على الآخرين. ثم يأتي الفريق الآخر، ويأخذ أيضًا من تلك الآيات الكريمة والأحاديث النبوية ما يناسبه، ويتجاهل كل الآيات التي لا تناسب موقفه. وهكذا يمكن أن نجد عشرات الآراء الفقهية والتفسيرات والتأويلات المختلفة والمتناقضة لقضية فقهية معينة. في هذه اللعبة كثيرًا ما يلجأ اللاعبون إلى تأويل النصوص لدرجة تخرجها من معناها البسيط والمباشر.
وهذا ما يقوم به كاتب التقرير النقدي في تعامله مع التفسيرات التي تقدمها بحوث مجلة قلمون للظواهر والموضوعات التي درستها. يقتطع فقرة من النصوص المكتوبة في المجلة، ويؤولها بالطريقة التي يريد، ويستخرج منها الأحكام التي تحلو له. ولا سيما أنه في العلوم الإنسانية المعاصرة يمكن القول إن أي تفسير لأي ظاهرة اجتماعية وسياسية قد يُقابل بتفسير آخر محتمل. وهذا يعني أن في العلوم الإنسانية تفسيرات عدة تتصارع لتقديم فهم أكثر علمية لظاهرة معينة. هكذا يمكن تقديم تفسير اقتصادي أو اجتماعي أو أخلاقي أو أنثروبولوجي أو ديني لظاهرة من الظواهر.
يستغل كاتب التقرير النقدي هذا الأمر ليقدم تفسيرات لبعض القضايا على الضد من التفسيرات الموجود في بحوث المجلة بدعوى أنها الأدق، وأن تلك البحوث أخطأت أو جانبت الصواب في تفسيراتها. حتى إنه لا يدلل على ذلك، أو لا يشغل باله بتقديم أدلة واضحة لتفسيراته، وكأنه هو شخصيًا الضامن صوابَ تفسيراته. ويقدم أيضًا تفسيرات محتملة وبديلة من التفسيرات الموجود في البحوث، غير أنها تفسيرات لا تقلل من أهمية التفسيرات الواردة في بحوث المجلة. لدرجة أنه يتجاهل أجزاء مهمة من البحث لكي يقول كلامًا لا يريد البحث أن يقوله. ولا بأس من العودة إلى بعض الأمثلة لتوضيح تلك الحيلة.
يُفسَّر تسامح الإيزيدية وانفتاحها من قبل كاتب بحث “الإيزيدية المكون الغائب من النسيج السوري” بأنه يعود إلى تعاليم الإيزيدية التي تدعو إلى التسامح، بينما يرفض كاتب التقرير النقدي ذلك التفسير، ويرجع تسامح الإيزيدية إلى قلة عددهم وضعف شوكتهم. المشكلة أن كاتب بحث الإيزيدية نفسه يشير إلى تفسير تسامحهم، في مكان آخر من بحثه، بقلة عددهم عندما يشير إلى أن شعورهم بأنهم أقلية جعلهم يتبنون مفهوم المواطنة في الدولة السورية[2]، وعندما يشير أيضًا إلى أن خارطة تحالفاتهم وتكتيكاتهم مع الأطراف المحلية السورية واللاعبين الدوليين التقليديين في المنطقة، خاصة أيام الفرنسيين والعثمانيين، كان بسبب وضعهم في سورية من حيث هم “تجمعات منسية صغيرة”[3]. وهذا يعني أن كاتب التقرير النقدي لا ينقد البحث المذكور بناءً على قراءة كاملة ودقيقة للبحوث، إنما يقوم بتصيد جمل هنا وفقرة هناك من دون أن يكبد نفسه مشقة قراءة البحوث وانتقادها بإنصاف. ما يزيد الحرج هو أن البحث الذي نتحدث عنه لا يشير فقط إلى أن الإيزيديين قليلو العدد وحسب، بل إلى أنهم يعون هذا الوضع، ويرسمون سياساتهم وعلاقاتهم بالمكونات الاجتماعية والدينية المجاورة، وبالدولة السورية، بناءً على ذلك، لدرجة أن إدراكهم هذا الوضع يكاد يتحول إلى قضية شبه بدهية في البحث المذكور، حيث يذكر الباحث هذه المعلومة ودلالاتها عشرات المرات. وهنا نكتفي بذكر بعضها: جماعة تسعى إلى ” المحافظة على كينونتها”[4]، “بوصفها مجموعة دينية صغيرة”[5]، “حماية الأقلية الدينية من الأكثرية”[6]، “الإيزيدية بوصفها مكونًا سوريًا مغيبًا من الدساتير السورية”[7]، خوّف النظام الإيزيديين من الثورة ولوح بإمكانية أن يبطش بهم كونهم أقلية”[8].
رابعًا: في مأزق النقد الذاتي والانتقائي
يقدم كاتب التقرير النقدي في كل زاوية من ورقته ملاحظات نقدية أبوية مفادها أن العمل لا يجب أن يكون على هذا النحو بل على هذا النحو. ولكي يمرر مثل هذه الملاحظات ويلبسها لباسًا موضوعًا يفرض مهمات معينة على المجلة القيام بها، وعلى ذلك، فالمجلة لم تحقق النجاح لأنها لم تقم بتلك المهمة التي وضعها هو للمجلة، علمًا بأن المجلة لا تفكر بتلك المهمة، ولا تريد أصلًا القيام بها، بل تعدها مهمة غير مجدية، وليست علمية.
على سبيل المثال، يطالب التقرير النقدي المجلة بتقديم “الترابط العضوي والتكامل بين الأبحاث التي يتضمنها (العدد الأخير من المجلة)، من خلال صياغة إشكاليةٍ محددةٍ واضحة المعالم تمثل الأبحاث أطروحاتٍ مختلفةً ومتكاملةً، للإجابة عن الأسئلة الرئيسة التي تتضمنها. كما كان يمكن وينبغي لكلمة العدد، بوصفها تقديمًا لأبحاث ملف هذا العدد، وعرضًا لأهم مضامين تلك الأبحاث، ونتائجها، أن تتضمن ضبطًا معرفيًّا، وصفيًّا ومعياريًّا، لعددٍ من أهم المفاهيم المستخدمة: الحداثة، الإسلام (السياسي أو الجهادي)، العلمانية …إلخ، وعرضًا للأسس النظرية التي تجمع وتميِّز بين الحداثات المختلفة والإسلامات المختلفة، والعلمانيات المختلفة … إلخ” (ص9).
هنا، لا بد من التذكير أن الباحثين الذين يكتبون في مجلة قلمون من مشارب ومدارس فكرية مختلفة، ولا يمكن أن يكون هناك تعريفات محددة للمصطلحات يوافق عليها الجميع، فضلًا على أن الأسس النظرية للبحوث وتعريف المفهومات واستخلاص النتائج أمر متروك للباحث نفسه، ولا علاقة لكلمة العدد بذلك، لأن كل كاتب هو الذي يحدد معنى مفاهيمه في بحثه، وهو الذي يستخلص النتائج التي يتوصل إليها. ولو أن كلمة العدد قامت بذلك الأمر، وفرضت على الكتّاب جميعهم تعريفات محددة للمفاهيم المستخدمة في البحوث لأسرع كاتب التقرير النقدي نفسه إلى القول بأن رئيس التحرير يفرض تعريفاته ومعاييره على الباحثين الذين يكتبون في المجلة.
لم يوضح كاتب التقرير النقدي لماذا على كلمة العدد القيام بكل تلك المهمات التي ألقاها على عاتقها، وهي مهمات تذكر بالمهمات التي قامت بها البيانات السياسية الكبرى في اللحظات التاريخية الفاصلة. لا نعرف لماذا لم يلاحظ التقرير النقدي وجود ذلك التوافق شبه الضمني بين كلمة العدد وبحوثه. ثم هل بالفعل على الكلمات الافتتاحية للمجلات العالمية أن تتضمن دائمًا ضبطًا معرفيًا ووصفيًا ومعياريًا للمفهومات المستخدمة في بحوث المجلات؟. يمكن المجادلة بأن هذا التقليد الذي يريد التقرير أن يلزم المجلة به ليس من التقاليد العلمية للمجلات العلمية المحكمة، وليس لزامًا على المجلات العلمية في العالم القيام بهذه الأمر في افتتاحياتها.
يضاف إلى ذلك أن التقرير النقدي يتناول العدد الأخير من مجلة قلمون بوصفه كتابًا لمؤلف واحد فقط، وليس مجلة تتضمن عشرات البحوث والدراسات لعشرات الكتاب والباحثين. وهي طريقة لجأ إليها درويش لكي يُلبس المجلة نوعًا من التنافر المفتعل بين بحوث المجلة المختلفة، أو بين كلمة العدد وتلك البحوث، أو للقول بأن فصول الكتاب لا يتناسق بعضها مع بعض وبينها اختلافات كبيرة، أو أن الكتاب (المجلة) استخدم بعض المفهومات بأكثر من معنى، وهي طريقة أقل ما يقال عنها أنها غير علمية.
مثل تلك الطريقة ساعدت درويش -مثلًا- على اختراع المشكلة الآتية:
يقول التقرير النقدي في الصفحة (12): “يخصص البحث الثاني أكثر من ثلاث صفحاتٍ للحديث عن “الجمعيات الإسلامية”، على الرغم من أن البحث الأول مخصصٌ بالكامل للحديث عن تلك الجمعيات، وبدون أن يقدم البحث الثاني ما يسوِّغ تكراره لتلك المعلومات”.
يعرف كاتب التقرير النقدي جيدًا أن بحوث المجلة كتبت بصورة مستقلة من قبل عدد كبير من الباحثين، ولا يمكن لهيئة التحرير المجلة حذف معلومات من أحد البحوث لأنها مكررة في بحث آخر. ولا سيما أن عددًا كبيرًا من القراء يختار بحوث معينة لقراءتها ولا يقرأ المجلة بشكل كامل. علاوة على أن الحذف قد يخل ببنية البحث نفسه. ثم ماذا سيكون رد فعل كاتب التقرير نفسه لو أن هيئة تحرير مجلة قلمون حذفت فقرات من بحثه بحجة أن المعلومات الموجودة في هذه الفقرات وردت في بحث آخر؟.
إن النظر إلى أبحاث المجلة، على أنها تشكّل كتابًا واحدًا لمؤلف واحد، ساعد التقرير النقدي أيضًا في النظر إلى الاختلافات بين البحوث، وهو أمر طبيعي، على أنها أمر غير طبيعي، وأن هناك خللًا ما في المجلة. هكذا يغدو من المستغرب -من وجه نظر التقرير النقدي – أن نجد بحثًا يتبنى المنظور العلماني، بينما يتبنى بحث آخر المنظور الإسلامي، أو أن نجد بحثًا يعنى بإشكالية معينة، في حين يعدها بحث آخر إشكالية ثانوية ويركز على إشكالية أخرى. ثمة بحوث ترى أن سورية لم تدخل في مرحلة الحداثة أصلًا، بينما ترى بحوث أخر أن سورية دخلت بطريقة ما في مرحلة الحداثة. هذه الاختلافات في وجهات النظر أمر طبيعي وحيوي، كما ذكرنا، بين بحوث كتبت من قبل عدد من الباحثين المختلفين في الرؤى والثقافات والمدارس الفلسفية، تثير ذهول كاتب التقرير النقدي من دون أن ينذهل من طريقته في قلب الأمور لإثبات أنها مقلوبة، على طريقة “سرير بروكست” الشهيرة، وهي طريقة يقوم فيها قاطع طريق يوناني بقص أطراف ضحاياه أو مطها حتى تتناسب مع طول السرير الذي يمددهم عليه. حتى إن التقرير النقدي يستخدم هذه الطريقة في أكثر من خمسة مواضع على الأقل. (راجع الصفحة 10 مثلًا).
قضية ذاتية أخرى يريد كاتب التقرير النقدي فرضها على مجلة قلمون وتتعلق، هذه المرة، بحجم البحوث المنشورة، وسعة موضوعاتها. ففي تعقيبه على أحد الأبحاث متناولًا “اتساع مساحة البحث وتأثير ذلك في مضامينه”، يقول درويش: “أفضت محاولة البحث تغطية تلك الفترة الطويلة إلى اقتصاره غالبا، على الأقل، على عرض معلومات عامة لا تقدّم أي إضافة معرفية (“مهمة”) غالبا، وعلى أن يكون مجرّد وصف عام وتحليل بسيط لا يخلو من التبسيط والأحادية في كثير من الأحيان” (ص 11). لكن ما قد يكون “عرض معلومات عامة لا تقدّم أي إضافة معرفية (“مهمة”)” من وجهة نظر درويش، ربما يكون جديدًا وإضافة (“مهمة”) لآلاف القراء وعشرات الباحثين والأكاديميين من غير المتخصصين في المجال المبحوث. وبناء على معايير درويش نفسه، ربما أمكن القول إنه هو نفسه سقط في العمومية والتبسيط، إذ “لم تتضمن الدارسة (التقرير النقدي) أي تقييم كامل لأي بحث من بحوث الملف، واكتفت بمناقشة ما جاء فيها “مناقشة عامة””، وفق وصفه هو نفسه ورقتَه النقدية.
خامسًا: حول التوظيف السياسي للدين في سورية
يهاجم كاتب التقرير النقدي عددًا من البحوث التي وجدت في التوظيف السياسي للدين إحدى القضايا التي استفاد منها النظام كثيرًا، ووظفها لمصلحته، معتبرًا أن التشابك بين الديني والسياسي أمر ليس دائمًا “شرًا” في ظل نظام استبدادي. ويضيف أن “التشابك، الجزئي، بين الدين والدولة، ما زال قائمًا في إنجلترا/ بريطانيا، وكذلك هو حال التشابك بين الدين والسياسة والدولة في ألمانيا، من دون أن ينفي ذلك وجود “حداثة سياسية” في هذين البلدين. والحديث عن أن الحداثة تقتضي، بالضرورة، العلمنة التي تتطلب، بالضرورة، عدم توظيف الدين في السياسة، وفض التشابك بينهما، يفتقر إلى ما يسوِّغه معرفيًّا. ويبدو ذلك الافتقار واضحًا، إذا أخذنا في الحسبان الانتقادات الشديدة التي وُجِّهت، في العقود الخمسة الأخيرة خصوصًا، إلى نظرية أو نظريات العلمنة القديمة التي كانت تتبنى مثل ذلك الطرح، وتروِّج له، لكنها أصبحت مهجورةً عمومًا، في العلوم الاجتماعية المعاصرة عمومًا، وفي علم اجتماع الدين خصوصًا، خلال العقود القليلة الماضية” (ص7).
يلجأ كاتب التقرير النقدي إلى التقسيم المصطنع للعلمانية إلى علمانيات، لإثبات بطلان البحوث التي تضمنها العدد الأخير من المجلة، والتي ترى أن توظيف الدين في السياسة كله شر، ولا يخدم سوى الأنظمة الفاسدة. والباحث هنا يلجأ إلى الخلط بين حضور الدين بوصفه موروثًا ثقافيًا واجتماعيًا في بريطانيا وألمانيا، وحضوره السياسي المباشر. العلمانية عمومًا واضحة جدًا في هذه النقطة، وليس للانتماءات الدينية ورجال الدين أي دور سياسي واضح في كيانات الدولة السياسة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية، والحديث عن توظيف الدين في السياسة، في بريطانيا وألمانيا، حديث لا يتعلق بوضع عام وسياسات دول، بأحسن الأحوال قد يتعلق بحادثة فردية هنا أو هناك.
ومن ثم، فإن تلك الحوادث الفردية لا تشكل حجة علمية يمكن أن يؤسَّس عليه موقف واضح من التوظيف السياسي للدين في سورية. في غالبية الدول العلمانية هناك حضور للديني في المجتمع عمومًا. هناك مثلًا مدارس تابعة لكنائس، تلفزيون رسمي ينقل الاحتفالات الدينية، جمعيات دينية تعمل خيريًا، وتجمع الأموال من الناس، مبشرون يطرقون أبواب البيوت ويدعون الناس لدين معين، أحزاب تضع رموزًا دينية على أعلامها …). ولكن هذه المظاهر ليست لها علاقة بالعلمانية وعلاقة الدين بالسياسة، هذه بكل بساطة قضايا اجتماعية ثقافية يمارسها الناس في حياتهم. أما الدولة فهي حيادية تجاه سلوكيات من هذا القبيل، حتى إنها تدعم في بعض الحالات نشاط المؤسسات الدينية، إذا وجدت في هذا النشاط ما يفيد المجتمع ككل، ولكن من باب مصلحة المجتمع، وليس من باب السماح للطبقة الدينية بممارسة دور سياسي في المجتمع.
في بحث “الدين والدولة وسؤال المأسسة: وزارة الأوقاف السورية أنموذجًا”، يوجه الباحث في بحثه نقدًا لـ “الأصولية الإسلامية”، ويجعلها أحد أوجه المشكلة في سورية، بل إن النظام السوري استفاد من مثل تلك الأصولية الموجودة على أية حال قبل قدومه، ووظفها، واستفاد منها عبر الطبقات الدينية ووزارة الأوقاف نظرًا للتشابه بين عقيدتي البعث وتلك الأصوليات. غير أن ذلك لا يعني -كما يحلو للتقرير النقدي أن يستنتج- أن هذا الكلام يصب في “التوجه العلمانوي الثقافوي الذي ينظر إلى الإسلام أو إلى الأصولية المرتبطة به، على أنها أسُّ أو أصل المشاكل” (ص 10). هنا نقع مرة أخرى في إشكالية قراءة مقتطفات من البحث قراءة سريعة، من دون التركيز على ما يريد أن يقوله الباحث من بحثه. أصل المشكلة في البحث المذكور هو النظام السوري، وليست الأصولية الإسلامية. النظام هو الطرف الأقوى، وهو من أبقى على القوى التقليدية كلها من أصوليات وغيرها، وهو الذي يوظفها ويستفيد منها بكل الوسائل التي يمتلكها. أما وجود هذه الأصولية قبله، وأنها كانت سلطة تقليدية متخلفة، وأنها من طينة الأيديولوجيات القومية، فهذه أمور متوافق عليها حتى عند الإصلاحيين الإسلاميين أنفسهم، ولا تفضي بالضرورة إلى علمانوية ثقافوية. فالبحث الذي نتحدث عنه يؤكد بوضوح شديد أن النظام السوري ومؤسساته الدينية “هي نفسها العامل الأهم في إنتاج الأصولية وأنماط جديدة من العمل والفكر الأصولي” [9].
وهنا نصل إلى القول بأنه عندما قال كاتب التقرير النقدي: “ما سبق ذكره حتى الآن يتعلق بمضمون العدد المزدوج عموما، وبمضمون ملفه عن “الدين والمجتمع” خصوصا، ومن منظورٍ جزئي ونسبي محدد” (ص26)، كان حريًا به القول: “من منظور مجتزأ واستنسابيّ انتقائي”.
سادسًا: لا تناقض بين الخبرات الشخصية والبحث العلمي
يجادل كاتب التقرير النقدي في تقريره حول “إيجابيات الاعتماد على الخبرة الحية والملاحظة بالمشاركة والفاعلين السياسيين ومحاذير ذلك الاعتماد وسلبياته” (ص 20). ويقصد بذلك أن عددًا من البحوث المنشورة في المجلة اعتمد على خبرات الكتّاب وتجربتهم الشخصية، وأن لذلك سلبياته، ويمكن أن يجرح الموضوعية العلمية لتلك البحوث. معتبرًا أن كتابة بعض البحوث من قبل أفراد من الطائفة نفسها عن طوائفهم أمر يخل بموضوعية البحث، وليس هناك ضمانات بأن الباحث لا يتعاطف مع طائفته.
في البداية لا بد من القول إن انجاز مثل تلك البحوث ذات الطبيعة الطائفية والإثنية الحساسة، مع المحافظة على قدر كبير من المهنية والعلمية، في الوقت نفسه، يعد من الإنجازات المهمة التي نجحت هيئة التحرير في تحقيقها. ونذكر هنا الجهد الصعب والمضني والطويل الذي بذله رئيس التحرير في المراجعة والتدقيق والتعديل، والتواصل مع الكّتاب، واختيار الكتّاب ذوي التكوين العلمي والموضوعي، حتى إن بعض البحوث كُتِب ثلاث مرات.
نصف هذا المنجز بالمهم لأن اقتحام موضوعات كهذه شبيه باقتحام حقل ألغام، عليك فيه أن تنتقد الفاعلين بقسوة، وتحّمل بعض الأطراف مسؤولياتها، وتهدم أوهامًا عمرها مئات السنين، من دون أن تثير الحساسيات الطائفية والمذهبية، أو تخلق نوعًا من سوء التفاهم. كما أن المجلة ترى أنه في بعض الحالات يمكن للخبرات الشخصية وتجارب بعض المنخرطين في شأن معين أن تكون أمرًا حيويًا، لا يقل أهمية عن المصادر التقليدية للتوثيق.
لم يتمكن التقرير النقدي من توجيه نقد له قيمة للبحوث التي كتبت عن الطوائف والإثنيات في سورية من قبل باحثين ينتمون للطائفة نفسها، ولم يجد ما يخل بعلمية تلك البحوث، وهذا دليل على أن تخوف التقرير النقدي من انزلاق مواقف الباحثين وتعاطفهم مع طوائفهم أمر كان الباحثون الذين كتبوا في مجلة قلمون متيقظين له بدرجة عالية، وهذا يعود طبعًا للشخصية العلمية الرصينة التي يتحلى بها كتّاب المجلة. ولأن كاتب التقرير النقدي لا يبدو أنه يعير اهتمامًا كافيًا لخصوصية الوضع السوري، وسياسات التلاعب بالجانب الديني، فهو لم ينتبه إلى هذا الخيار الصعب الذي أخذته المجلة على عاتقها، أي حساسية أن يقوم طرف بنقد طائفة وأوضاعها الدينية والاجتماعية، وهو ليس من هذه الطائفة. فالمجلة مدركة أنها تتعامل مع مستبدين شرسين يمكن أن يتلاعبوا بأي شيء، استخدموا سياسات “التنميط” السلبي على السوريين منذ عشرات السنين.
يتصور الكاتب في بعض الأحيان عيوبًا لا وجود لها في النص، والهدف هذه المرة هو بحث الإيزيديين مرة أخرى، والحجة أن البحث فيه حديث إيجابي ووردي عن الإيزيديين وأدوارهم الوطنية، ومحاربتهم الفرنسيين، وانخراطهم في المقاومة الفلسطينية، وأن هذا “تحيز” و”منظور جماعاتي ضيق” (19). علمًا بأن البحث نفسه يتحدث في فقرات أخرى عن مشكلات الإيزيديين، وتغيير مواقفهم، ووجود فئات من داخل الطائفة تتلاعب بهم، وأنهم في النهاية مجموعات غير متجانسة فكريًا وسياسيًا، ويعانون تكاثرَ المرجعيات المحلية والحزبية والمدنية الإيزيدية التي تتلاعب بهم وفق “أجنداتهم الخاصة”، وقد تعرضوا مثلهم مثل بقية مكونات المجتمع السوري إلى انقسامات بينهم حول طريقة التعامل مع النظام الاسدي وقوى الثورة السورية. ومثلما حاربوا الفرنسيين في مرحلة ما، فإنهم تعاونوا مع الفرنسيين في مراحل أخرى، حتى إن الفرنسيين منحوا شيوخهم “ألقابًا”، وأمنوا لأبنائهم بعثات دراسية، مثلما تطوع الشباب الإيزيدي في الجيش الفرنسي[10]. وهذه قضايا تثير حساسيات ضمن البيت الإيزيدي الداخلي، أو الأطراف السورية الأخرى، وليست بصورة مؤكدة حديثًا ورديًا ومديحًا في الإيزديين.
سابعًا: التوصيات العلمية للبحوث
يقدم عدد من الباحثين في خواتيم بحوثهم بعض “التوصيات” في نوع من الاستنتاجات العلمية، ومقترحات لمعالجة المشكلة المطروحة. يدين كاتب التقرير تلك التوصيات، ويصفها بدعوات أخلاقية لا تليق ببحوث معرفية، وأنها مجرد أيديولوجيا تحمل “نفسًا دعويًّا” يؤثر بالتأكيد في علمية البحوث (ص 14)، علما بأن أغلب رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث المحكمة في جامعات العالم كافة تحتوي في خواتيمها على “توصيات” يقدمها الباحث، ويضمنها مقترحات لمعالجة المشكلة أو القضية المطروحة، انطلاقًا من تحليله الظاهرةَ التي يدرسها، والخبرات التي كونها في أثناء البحث. مع العلم أن التوصيات التي يدرجها الباحثون ضمن خواتيم بحوثهم هي معظمها توصيات للمعالجة في ضوء ما حدده الباحث للمشكلة من أسباب، أي إن تلك الخواتيم هي في النهاية جزء من بنية البحث العلمية، وليست نصائح أخلاقية تحمل نزعة وصائية، أو انحيازًا للفئة التي يدرسها الباحث.
يأخذ كاتب التقرير النقدي -مثلًا- على بحث “في أسباب الحضور الباهت للتديّن الدعوي في الثورة السورية” أن خاتمته تتضمن مطالبة رجالات الإسلام الدعوي في سورية “بإعادة حساباتهم بشكل جذري، وتشجيع الناس على طلب حقوقهم من الحكام ولو بالقوة، ونبذ الفتاوى التي تنافق للأنظمة، والتخلي عن الجري وراء مصالحهم الشخصية والاستمتاع بالنجومية”، بحجة أن هذه التوصية أيديولوجية، وليست معرفية. علمًا بأن البحث يدلل على قضية أساسية تقول: إن رجال الدين الدعوي في سورية ليست لديهم قضية دينية أو سياسية، كما يوهمون الناس، وإنهم في النهاية أقرب للنجوم الرياضيين والفنيين، ولأنهم ليس لديهم قضية، فهم يتراخون في مواقفهم تجاه النظام، ويخدمونه بصورة غير واعية، وفي بعض الأحيان بصورة واعية. فمثلًا تفسيراتهم للثورة السورية بأنها “ابتلاء من الله”، وأن مشكلة السوريين تعود إلى تهاونهم في واجباتهم الدينية أو تراجع صلة الأرحام بينهم، هي في النهاية تصب في صالح النظام الذي يصفق بدوره لأي تفسير للثورة بعيدًا عن فساده وظلمه ونهبه للسوريين لمدة خمسين عامًا. وعلى ذلك فإن التوصية التي تطالب الدعاة الدينيين بمراجعة مواقفهم، والتنبه إلى أن النظام يستفيد منهم أكثر مما هم يتوقعون، هو أمر يصب في صلب البحث، وليس محض نصيحة أيديولوجية، ودعوة لفئة الدعاة بأن يدركوا دورهم السلبي، ويكفوا عن أن يكونوا مجرد شخصيات جامعة للمال وباحثة عن الشهرة -وهي قضية عرفها النظام جيدًا، واستغلها من أجل شراء ولاء عدد منهم، والبحث يتوسع في هذه النقطة- وأن يتحولوا إلى شخصيات داعية لحقوق السوريين.
ثامنًا: هل التوثيق حاجة علمية أم وسواس؟
يأخذ كاتب التقرير على أحد البحوث -مثلًا- قوله بأن الشيخ أحمد كفتارو كان مؤيدًا للنظام، من دون أن يوثق البحث هذه المعلومة من كتابات أو لقاءات أو تصريحات لأحمد كفتارو، وأن هذا أمر يجرح الصدقية العلمية للبحث (ص 23). يعرف كاتب التقرير النقدي جيدًا أنه بالنسبة إلى المواقف المعروفة والمعلومات المنتشرة انتشارًا واسعًا، ويمكن معرفتها بسهولة، فإن الأمر لا يحتاج إلى توثيق علمي. الصور التلفزيونية التي تظهر أحمد كفتارو متأبطًا يد حافظ الأسد شاهدها السوريون معظمهم في الأعياد لنحو 30 عامًا. كما أنه بوصفه مفتيًا للجمهورية العربية السورية يُعَيَّن من الرئيس تعينًا مباشرًا وفق الدستور السوري، وقد بقي كفتارو في منصبه طيلة المدة التي حكم فيها حافظ الأسد سورية، ولم يترك منصبه حتى وفاته عام 2004، ومن ثم، ليس هناك أي ضرورة علمية لتوثيق هذه المعلومة، إلا إذا كان هناك التباس معين أو مشكلة جديدة ظهرت، ويريد البحث مراجعتها.
تاسعًا: حول التوثيق واللغة وعلامات الترقيم
خصص درويش حوالى ربع تقريره لقضايا لغوية تتعلق بلغة البحوث وعلامات الترقيم وطرق التوثيق. وإذا كان هناك بالفعل بحوث تحتوي على أخطاء اللغوية، وعدم دقة في علامات الترقيم، وتحتاج إلى تصحيح، فإن هيئة التحرير تتحمل مسؤولية مثل تلك الهفوات، وتعد باستدراكها في الأعداد القادمة، ولا سيما أن التقرير النقدي بالغ كثيرًا في حجم تلك الأخطاء.
تجاوز عدد كلمات عدد مجلة قلمون المزدوج 230 مئتين وثلاثين ألف كلمة، وحوالى نصف البحوث أنجزها الباحثون أو وصلت إلى قسم التحرير في الشهر نفسه الذي ينبغي أن يصدر فيه العدد، ما يعني أن ضغط حجم العمل وزمن النشر يفرضان نفسهما على محرر واحد في المجلة، ومن ثم فالهامش لهنات وهفوات صغيرة موجود وطبيعي.
تعمل مجلة قلمون بنظام مدقق واحد فقط هو الذي يقرأ ويراجع في الوقت نفسه، ونتمنى أن يتاح لها الفرصة أن تعمل بنظام المدقق الأول ثم المراجع الثاني، كما هو متبع في المجلات الأخرى، في حال توافرت الإمكانات. ولذلك فإن من يقرأ عشرات الصفحات قد يعتاد النظر في الملف، فلا ينتبه إلى وجود نون في آخر كلمة بدلًا من الفاصلة، أو إلى أن همزة “أو” غير موجودة، وهذا ما حصل في بعض الملاحظات الواردة في تقرير درويش، ولكنها على الرغم من ذلك هفوات معدودة، ولا تؤثر في فهم معنى النص، لا كما قال التقرير أنه يجب أن يعاد تحرير المجلة كلها من كثرتها. إن أحكامًا من مثل “أخطاء كثيرة، غير معدودة، ….” أحكام غير علمية وغير موضوعية.
يضاف إلى ذلك، ثمة أخطاء افترض التقرير أنها أخطاء، لكنها ليست كذلك. في المجلة سياسة تحرير واضحة تتعلق بـ “الأخطاء الشائعة” أي كلمات شاع استخدامها الخاطئ بين الناس، وهذا ما وقع فيه التقرير أيضًا. يضاف إلى ذلك أخطاء لا يسمح لأي مدقق أو محرر التدخل فيها، وهي أخطاء الشواهد والمقبوسات، أي إن الكاتب استند إلى شاهد من كتاب منشور سابقًا لكاتب آخر، وقد ورد في هذا الشاهد أغلاط لغوية، فإن الأمانة العلمية تفرض علينا قبول الشاهد بأخطائه من دون التدخل فيه، أي ينتهي عمل المحرر والمدقق عند حدود هذه الشواهد.
نشر العدد المزدوج أكثر من أربعين دراسة لأربعين كاتبًا، كل منهم يستخدم أسلوبًا في الكتابة والتحرير والترقيم والفهرسة، تعاد الدراسات كلها إلى أصحابها مرة ومرتين وثلاثًا لحثهم على الالتزام بسياسة التحرير المتبعة في المجلة، والمنشورة في موقع مركز حرمون منذ سنوات، وقلة من تلتزم بها، وليس منهم درويش بحسب بحوثه التي وصلتنا منه، هذه العملية تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، لا يوفرهما قسم التحرير أبدًا، لكن لا يمكن إثقال الكتّاب بأكثر من ست مراجعات، فهذا يعني أننا سنستغرق في كل عدد سنة، حتى نرضى عنه. عندئذ يحاول المحرر استدراك كل ما غفل عنه الكتاب، ولنقل يصل النص المنشور إلى مستوى عالٍ من الجودة، وهذا في عرف عمل المدقق جيد وكاف.
يضاف إلى ذلك صعوبة تقنية لا لغوية ترتبط بالأقواس وعلامات الترقيم، فالنسخ التي ترسل إلى الإخراج تخضع لتعديلات أخرى غير متوقعة، ولبرنامج الإخراج معاييره في فهم النص والتعرف إليه، فيحدث تغييرات غير مطلوبة منه، وغير موجودة في نسخة التحرير، كأن لا يقبل الأقواس التي أشار إليها التقرير، أو أن يستبدل بها غيرها من دون قاعدة محددة، ومرد ذلك إلى أن برامج الإخراج ما زالت غير موجهة للمحتوى باللغة العربية، وثمة عيوب كثيرة في خطوط اللغة العربية، وهما مشكلتان لا يمكن حلهما جذريًا، لكن المحاولات حثيثة للحد من آثارهما، ما استطاع المحرر إلى ذلك سبيلًا.
ولعلّ عنوان فقرة وضعها درويش في معرض نقده لأحد الأبحاث: “الخلط بين ما هو كائن وما يجب أن يكون” (ص 16) يعطي فكرة -بدرجة ما- عن طريقة درويش بالنقد والخلط الذي يعتورها، بغض النظر عن البحث الذي أراد نقده. ذلك أنّ “النقد” عنده عمومًا ينصبّ على “ما هو كائن” لا لعلّة فيه بالضرورة، بقدر ما أن درويش يريده “أن يكون” منسجمًا مع فهمه ومسطرته. وهو أعطى وعظًا مدرسيًّا في منهجيات البحث (ص 26، وما بعدها)، ثم تدخّل في أسلوب الكتّاب اللغوي (ص 32-33)، فتارة لا تعجبه الجمل القصيرة والفقرات المؤلفة منها، وتارة لا تعجبه الجمل الطويلة التي تشكّل فقرة واحدة. في المحصّلة هذه أساليب في الكتابة، ومن حق كل كاتب أن تكون له بصمته أو أسلوبه الخاص.
خاتمة
يبدو أن مجلة قلمون، بريادتها في فتح ملفات سورية مهمة وحساسة، وبتقدمها في وصف الظواهر السورية وتحليلها، وبانفتاحها على الكتاب السوريين من مختلف التيارات السياسية والفكرية، وبمحاولتها الإسهام في التأسيس لعلوم إنسانية واجتماعية سورية تتفاعل مع الوضع السوري الجديد، وتستفيد من العلوم الإنسانية العالمية، قد أصبحت محط اهتمام الأوساط الثقافية والسياسية السورية، ونقدها، وهذا أمر طبيعي ومفيد للقراء والمجلة على حدٍ سواء.
تستعد المجلة لطرح موضوع العقد الاجتماعي السوري في (العدد القادم) على بساط البحث، وتدعو الكتاب السوريين لمناقشة هذا الموضوع الحيوي، آملة من خلاله في تقريب وجهة نظر السوريين حول مستقبل سورية، وزرع الثقة من جديد بينهم من أجل التعاون في بناء سورية تكون للجميع على أساس الحقوق والحريات والمساواة لأفراد المجتمع السوري كلهم، هذا المجتمع الذي عانى على مدار نحو خمسين عامًا الظلمَ والقهر والنهب، ومُنع من أبسط حقوقه المدنية والسياسة وحتى الثقافية. ونقول “زرع الثقة”، لأن سياسة “فرّق تسد” التي مارسها النظام الأسدي لعقود من الزمان، وحشد لها الوسائل والإمكانيات الممكنة كلها فعلت فعلها، ولا بد من مواجهة آثارها السلبية.
وتعد مجلة قلمون قراءها والسوريين جميعهم بأنها لن تتراجع عن مشروعها الذي يريد تحويل الثقافة إلى ساحة عامة لمناقشة الأوضاع العامة للسوريين، مشروعها الذي يتيح للسوريين جميعهم الاستماع إلى بعضهم، ونقد بعضهم، والتعبير عن مخاوفهم بعضهم من بعض، وفضح كل قوى الاستبداد التي عاناها ويعانيها السوريون. وأداتها في ذلك نقد أوضاعهم السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية، وتحليلها بمستوى عال من العلمية والأكاديمية.
في السياق السوري، تعدّ نظرية “الثقافة للثقافة” كذبة كبرى تسعى مجلة قلمون لتعريتها، وثمة عدد من المثقفين السوريين يمارس الثقافة للثقافة، بقصد الوجاهة والشهرة وجني مكاسب فردية. الثقافة بمفهوم “مجلة قلمون” همٌّ وطني قبل كل شيء.
[1] سنشير إلى فقط إلى أرقام صفحات مقالة حسام الدين درويش المعنون: ” بين الثقافة والسياسة – دراسة نقدية لملف مجلة قلمون “التفاعل بين الدين والمجتمع في سوريا 1920-2020”, والمنشورة في موقع مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
[2] عبد الناصر حسو، “الإيزيدية المكون الغائب من النسيج السوري”، مجلة قلمون، ع13، 14، (مركز حرمون للدراسات المعاصرة، كانون الأول/ ديسمبر 2020)، ص335.
[3] المرجع السابق نفسه، ص335.
[4] المرجع نفسه، ص335.
[5] المرجع نفسه، ص 336.
[6] المرجع نفسه، ص338.
[7] المرجع نفسه، ص 340.
[8] المرجع نفسه، ص 340.
[9] حمود حمود، “الدين والدولة وسؤال المأسسة: وزارة الأوقاف السورية أنموذجًا”، مجلة قلمون، ع: 13، 14، (مركز حرمون للدراسات المعاصرة، كانون الأول/ ديسمبر 2020)، ص 361- 362.
[10]عبد الناصر حسو، الإيزيدية المكون الغائب من النسيج السوري، مرجع سابق، ص335.
مركز حرمون
———————————
المقال الأصلي
بين الثقافة والسياسة.. دراسة نقدية لملفّ مجلة قلمون/ حسام الدين درويش
صدر، في كانون الثاني/ ديسمبر 2020، عددٌ مزدوجٌ (13-14) من مجلة قلمون التي يصدرها مركز حرمون للدراسات المعاصرة، بالتعاون مع الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية. وحمل ملفّ ذلك العدد عنوان “التفاعل بين الدين والمجتمع في سورية 1920- 2020“. وعلى الرغم من العمر القصير للمجلة الذي بدأ عام 2017، وأنجب أربعة عشر عددًا فقط حتى الآن([1])، فإن المجلة احتلت موقعًا متميزًا ورئيسًا في “المجال الثقافي السوري العام”، ليس بسبب حالة الفراغ (شبه) الكامل التي يشهدها هذا المجال فحسب، بل بسبب راهنية الموضوعات التي تناولتها المجلة، وأهميتها، والقيمة المعرفية الفعلية والمتميزة التي قدمتها المجلة، وأفسحت مجال تقديمها وتناولها وتداولها لعددٍ من الكتاب والباحثين، أيضًا. فلم يكن لراهنية المواضيع التي تناولتها المجلة، ولأهميتها الكبيرة، أن تفضيان بالضرورة إلى إنتاجٍ معرفيٍّ مهمٍّ، لولا نجاح المجلة في استقطاب عددٍ من الأقلام المهمة وتحفيزها والتفاعل معها، تفاعلًا إيجابيًا ومناسبًا، أفضى إلى إنتاج عددٍ غير قليلٍ من النصوص المهمة والرائدة.
وقد بدا أن المجلة حريصةٌ على اتسام المواضيع التي تتناولها بالراهنية والأهمية، في الوقت نفسه. وظهر ذلك واضحًا في تناولها لعددٍ من أعلام الفكر السوري (العربي) المعاصر: صادق جلال العظم (العدد الأول، أيار/ مايو 2017)، ياسين الحافظ (العدد الثالث، تشرين الأول/ أكتوبر 2017)، جورج طرابيشي (العدد السادس، تموز/ يوليو 2018)، طيب تيزيني (العدد التاسع، أيلول/ سبتمبر 2019)، ولمواضيع أخرى مثل موضوع “الأكراد” (العدد الثاني، آب/ أغسطس، 2017)، وموضوع “المثقف في المنطقة العربية” (العدد الخامس، نيسان/ أبريل 2018). وكان واضحًا سعي القائمين على المجلة إلى الجمع بين النظري والعملي، بين الثقافي والسياسي، بين المعرفي والأيديولوجي. وعلى هذا الأساس، يمكن أن نفهم أن تعطي المجلة، من جهةٍ أولى، اهتمامًا كبيرًا بالإنتاج الثقافي السوري، الفني والأدبي، ﻟ “النخبة”، في العددين السابع (تشرين الأول/ أكتوبر 2018) والثامن (نيسان/ أبريل 2019) المخصصين، على التوالي، ﻟ “السينما السورية” و”الرواية السورية”، وفي العدد الثاني عشر (حزيران/ يونيو 2020) المخصص ﻟ “سيميائيات السرد القصصي لدى زكريا تامر”، وأن تفرد، من جهةٍ ثانيةٍ، اهتمامًا خاصًّا بمسائل عمليةٍ وسياقيةٍ مهمةٍ، مثلما حصل في ملفها عن “تعليم السوريين ما قبل الجامعي في تركيا”، في العدد الحادي عشر (آذار/ مارس 2020).
1- الجمع الإشكالي بين الثقافة/ الاهتمام النظري والسياسة/ الانهمام العملي
يبلغ الجدل والتفاعل، بين الاهتمام النظري والانهمام العملي، ذروته، في العدد المزدوج الأخير المخصص للحديث عن “التفاعل بين الدين والمجتمع في سورية 1920- 2020″، وفي العدد القادم، المتوقع صدوره في آذار/ مارس 2021، والمخصص لموضوع “الدولة الوطنية والعقد الاجتماعي في سورية”([2]). ولا نقول ذلك تخمينًا (فقط)، وكذلك لا يمكن وصف هذا القول بأنه مجرد استنتاجٍ أو منظورٍ شخصيٍّ؛ فهذا هو (أيضًا) الفهم الذي تقدمه المجلة ذاتها عن ذاتها عمومًا، والذي رأى القائمون عليها ضرورة إعادة التذكير به، في العدد المزدوج الأخير خصوصًا. ففي “كلمة العدد” التي كتبها الدكتور يوسف سلامة، بوصفه رئيس تحرير مجلة قلمون، ثمة تشديدٌ على البعد الأيديولوجي/ السياسي للمجلة وللمعرفة أو الثقافة التي تسعى إلى الانشغال بها. فثمة قضايا «تكرّس المجلة نفسها لمناقشتها، والدعوة إليها، والدفاع عنها، في مقابل ما ينبغي دحضه ورفضه من الأوهام المنبعثة من الماضي أو الماثلة في الحاضر التي يتطلع النظام إلى فرضها على السوريين، قبل الثورة وبعدها، بوصفها مسارًا ومآلًا يتعذر على السوريين تجنبه أو تخطيه» (ص 9) ([3]).
هذا التقابل بين قطبين مانويين، ندافع عن أحدهما أو ندعو إليه ونشيد به، من جهةٍ، ونرفض القطب الآخر أو نهاجمه أو ننتقده ونبيّن سلبياته، من جهةٍ أخرى، من العلامات أو القرائن القوية الدالة على وجود الفكر الأيديولوجي. ولا ينبغي أن نفهم الأيديولوجيا هنا بمعنًى أحاديٍّ سلبيٍّ لا يرى فيها إلا فكرًا زائفًا له مضامين ونتائج وأبعاد سلبية، كثيرة وكبيرة، بالضرورة. فنحن نرى أن الأيديولوجيا محايثةٌ للفكر عمومًا، وفي مثل هذه السياقات خصوصًا. والأيديولوجيا، التي نتحدث عنها، هي منظومةٌ، واعية أو غير واعية، جزئيًّا أو كليًّا، من الأفكار والقيم والمعايير والمصالح والرغبات والتطلعات والتفضيلات، والتوجهات المعرفية والمعيارية، وفق الرؤية المنظورية لتلك المنظومة. ويمكن للأيديولوجيا أو للمعرفة الأيديولوجية أن تتنافى مع المعرفة الموضوعية، ويمكن لها، في المقابل، أن تتقاطع وتتكامل معها، بطريقةٍ ومضمونٍ إيجابيين.
من حيث المبدأ، من الإيجابي أن يكون هناك وعيٌ وإقرارٌ بالأيديولوجيا المتبناة، أو تبنِ صريحٌ لأيديولوجيا ما. فالأيديولوجيا المنكرة لذاتها، أو غير المعترف بها، قد تكون “أسوأ الأيديولوجيات”، من حيث ممارستها لتأثير لا يمكن ضبطه ومناقشته وتقويمه بصراحة ووضوحٍ وتعمقٍ. وتعلن “مجلة قلمون” صراحة بُعدها الأيديولوجي في إطار حديثها عن العلاقة الضرورية والوثيقة، بل الماهوية، بين الثقافة والسياسة، وعن سعيها إلى لعب دور سياسي؛ لكنها تشدد، في المقابل، على أنها تسعى إلى القيام بذلك عن طريق الثقافة فقط. ومن هنا؛ فإن السؤال ليس عن البعد السياسي/ الأيديولوجي للعمل الثقافي أو الدور السياسي/ الأيديولوجي الذي (تريد أن) تقوم به المجلة، وإنما عن ماهية هذا البعد، وذلك الدور، ومضامينهما. والأيديولوجيا أو السياسة التي تتبناها المجلة هي أيديولوجيا حداثية، أو بالأحرى حداثوية، فهي تهدف، (في نهاية المطاف)، إلى أن “يدخل السوريون عالم الحداثة الذي لم يدخلوه بعد، بالتأكيد” (ص 9)، من وجهة نظر المجلة. والثقافة التي تتحدث عنها المجلة لا تكمن في “مجرد المعرفة” أو في “المعرفة المجردة”، إنما في «براكسيس اجتماعي، مهمته الدفاع عن (اقتصاد العدالة) بأوسع معانيها، وعن حقوق النساء والرجال المتساوية في التعبير عن أنفسهم تعبيرًا حرًا، وعن حقهم في صنع حياتهم الخاصة، واختيار نمط العيش الذي يؤثرونه، ما دام غير متعارض مع النظام العام، ولا ينتقص من حقوق الآخرين شيئًا» (ص 9). فالجدل بين المعرفة والأيديولوجيا، بين الاهتمامات النظرية والانهمامات العملية، بين الثقافة والسياسة، يفضي إلى تغيّر جوهري في طبيعة المعرفة، يتجسَّد في الابتعاد عن كونها “مجرد معرفة” أو “معرفة مجردة”، وفي طبيعة الأيديولوجيا التي تحاول التأسُّس معرفيًّا والتأسيس لمعرفةٍ تأخذها في الحسبان.
سأحاول، في ما يلي، تقديم قراءةٍ مكثفةٍ وسريعةٍ وجزئيةٍ ومنظوريةٍ لهذا الجدل بين الثقافة والسياسة، بين المعرفة والأيديولوجيا، بين الموضوعية والذاتية، في النصوص التي تضمنها العدد المزدوج المذكور للمجلة عمومًا، وملفه عن “التفاعل بين الدين والمجتمع في سورية 1920- 2020” خصوصًا. ومن الضروري التشديد على طبيعة العلاقة أو العلاقات الفعلية أو الممكنة بين طرفي هذا التقابل: لا تمثل الذاتية نقيضًا للموضوعية فقط، بل هي، أيضًا، طريقها الوحيد أو الضروري، فلا موضوعية إلا من خلال ذاتيةٍ ما. ومن هنا، تأتي ضرورة البحث عن طبيعة التفاعل بين الطرفين، بعيدًا عن تحويل الثنائية إلى مثنوية، واختزال العلاقة بين طرفيها إلى تناقضٍ يُقصي كلّ طرفٍ فيه الطرف الآخر. ويمكن تكرار الفكرة أو الأطروحة ذاتها، تقريبًا، في العلاقة بين المعرفة والأيديولوجيا، بين الثقافة والسياسة.
2- التمييز بين الوصفي/ التحليلي والمعياري/ التقويمي
لا ينبغي للحديث عن جدلٍ بين طرفي ثنائية الثقافة والسياسة، أو ثنائية المعرفة والأيديولوجيا، أن يُفضي بنا إلى تجاهل التمايز، الجزئي والنسبي، بين طرفي كلّ ثنائية. والتذكير بأهمية التمييز أو التمايز المذكور يبدو واضحًا، في سياق الحديث عن التمييز/ التمايز بين ما هو وصفيّ وتحليليّ، من جهة، وما هو معياريّ وتقويميّ، من جهة أخرى. وينبغي لأيّ بحثٍ معرفي أن يتأسس على ما هو وصفيّ، ومستقلّ، جزئيًّا ونسبيًّا، قدر المستطاع، عمّا هو معياريّ وتقويميّ. فمثلًا، عند الحديث عن ظاهرةٍ ما، ينبغي الانطلاق من فهمٍ أو تعريفٍ أو مفهومٍ وصفيٍّ وتحليليٍّ لتلك الظاهرة، بغض النظر عن موقفنا العقائدي/ السياسي/ الأيديولوجي منها. ولا يبدو أن هذا ما يحصل في بعض نصوص مجلة قلمون وملفها المذكور. ويبدو ذلك واضحًا في “كلمة العدد”، وفي عددٍ من النصوص التي يتضمنها ذلك العدد. ففي “الكلمة المذكورة” يتم تبني أيديولوجيا حداثوية لا ترى في الحداثة إلا ما هو إيجابيّ، وتتحدث “الكلمة” عن “الحداثة الحقيقية” التي يبدو أن لا خلاص ولا حول ولا قوة إلا بها. فالحداثة، هنا، مفهومٌ معياريٌّ، وأحاديٌّ في معياريته، بالدرجة الأولى، وهو مختزلٌ في مجموعةٍ من السمات والقيم والأفكار الإيجابية المرغوبة. فهل هذا ما يمكن وما ينبغي للباحث أن يقتصر على رؤيته في هذا السياق؟ لقد تعرّضت الحداثة لنقدٍ شديدٍ، حتى من قِبل عددٍ كبيرٍ من الحداثويين المتبنين لها والمدافعين عنها، في حين أن تلك الرؤية المعيارية الأحادية تختزل حقيقة الحداثة أو “الحداثة الحقيقية” في منظورٍ سياسيٍّ/ أيديولوجيٍّ/ ذاتيٍّ، بعيدًا عن الرؤية المعرفية الموضوعية المتوازنة الضرورية، في مثل هذه السياقات خصوصًا.
هذا التناول المعياري للحداثة، ولكثير من المفاهيم الأساسية الأخرى، يجد صداه لا في “كلمة العدد” فحسب، بل في قسمٍ كبيرٍ من نصوص ذلك العدد، أيضًا. ولا يتسق استخدام مصطلح/ مفهوم “الحداثة”، في بعض النصوص، مع المعنى المعياري للمفهوم في “كلمة العدد”. فمقابل نفي “كلمة العدد” لدخول السوريين و”منطقة الشرق الأوسط بأكملها” عالم الحداثة، هناك حديثٌ، في نصٍّ ثانٍ، عن تبني الطبقة العليا في سورية قيم الحداثة (ص 42)، وعن “دخول قيم الحداثة” إلى العشيرة (ص 87)، وتغلغلها التدريجي فيها (ص 91)، إلى درجة يمكن معها الحديث عن “ترسخ قيم الحداثة”، و”شيوع” هذه القيم، فيها” (ص 99-100). ومن الواضح وجود تنافر، أو عدم اتساق، بين هذا الحديث “الوصفي” عن الحداثة، وذاك الحديث “المعياري” لكلمة العدد. وثمة إمكانيةٌ في أن يُسهم ذلك التنافر في اضطراب معنى المفهوم، وازدياد احتمالات حصول سوء الفهم أو عدمه، في التواصل المعرفي/ اللغوي. لكن الخطاب المعياري لكلمة العدد يجد سندًا له في تناولٍ معياريٍّ مماثلٍ تقريبًا، في عددٍ آخر من نصوص المجلة. ولعل مضمون نص “كيف يتحول «النموذج الثقافي» إلى سلطة؟” هو أكثرها أحاديةً ومعياريةً واتساقًا مع “كلمة العدد”، حيث إنه يتقاطع مع تلك الكلمة القائلة بأننا “لم ندخل عالم الحداثة بعد”، ويذهب إلى درجة الحديث عما يمكن تسميته ﺑ “الاستثناء العربي”، إذ يرى أنه «لا يوجد حداثة في العالم إلاّ في الثّقافة العربيّة، تركن إلى منجزاتها ونتائجها»، وقد أفضى ذلك، وغيره، إلى أن «فُرّغت الحداثةُ بهذا من درسها الحقيقيّ، وأصبحتْ تزييناتٍ وزخرفاتٍ على ثوبٍ هو بالأساس يتعارضُ مع طبيعة الحداثة» (ص 546). وتفريغ هذه الحداثة من درسها الحقيقي يعني أنها “في نهاية المطاف” لا تنتمي إلى “الحداثة الحقيقية” التي تحدثت عنها “كلمة العدد”.
وكما هو “متوقعٌ”، فإن مثل هذه المقاربة المعيارية لمسألة الحداثة تتضمن نزوعًا أيديولوجيًّا يضعنا ويضع “ثقافتنا (الدينية)” عمومًا، والإسلام (السياسي) خصوصًا، في قطبٍ مناقضٍ لقطب الحداثة. والتناقض هنا ليس تناقضًا وصفيًّا فحسب، بل هو تناقضٌ معياريٌّ بالدرجة الأولى. ووفقًا لذلك التناقض، تقوم هذه الثقافة على نموذجٍ مقدّسٍ وتقديس نموذجٍ، وهي تتعارض بذلك جذريًّا مع “جوهر الحداثة”، «لأنّ الذّهن العربيّ في أعماقه المترسبة لم يتمكّن في مجالات كثيرة من التّحرّر من تقديس النّموذج، فنقلَ القداسة من نموذج وأسقطها على نموذج آخر، وبقي يدور في الدّوامة نفسها» (ص 546). ووفقًا لهذه الرؤية، فإن العائق الأساسي أمام الفكر العربي لا يتمثل في الاستبداد أو الاقتصاد أو علاقات القوة والهيمنة.. إلخ، وإنما يتجسد في “نموذج النص المقدس”، وقد “أصبح نموذجًا ذا سلطة مطلقة ومغلقة” (ص 543).
ويتبنى نص “الدين والدولة وسؤال المأسسة: وزارة الأوقاف السورية أنموذجًا” هذه النظرة، تبنيًّا جزئيًّا ونسبيًّا، على الأقلّ، حين يتحدث عن “فوقية الحداثة والفشل في تبييئها وإعادة إنتاجها ضمن معظم المجتمعات المسلمة” (ص 351)، وعن التسليم بأن «الإسلام السياسي وتراث الدولة الحداثي بقيا دائمًا ضدين، وإلى يومنا هذا» (ص 352). ونجد هذه النظرة المعيارية الأحادية إلى مفهوم الإسلام السياسي مهيمنةً في بحث “إشكالية التوظيف السياسي للدين في المجتمع السوري خلال الحكم الأسدي (2020 – 1970)”. فوفقًا لهذا البحث، فإن «توظيف الدين في السياسة فعل طائفي بامتياز» (ص 275)، وما ينتجه هذا التوظيف من دين/ إسلام سياسيٍّ هو شرٌّ بالضرورة، وإن “تأسيس علاقات وطنية ديموقراطية بين مواطنات ومواطنين متساوين”، و”بناء علاقات مواطَنة حديثة”، يقتضي “بالضرورة”، كمدخلٍ لا بدّ منه، “فكّ التشابك بين السياسي والديني في المجتمع السوري” (ص 263-264).
لا تكترث مثل هذه المقاربات الأيديولوجية/ المعيارية/ السياسية لهشاشة موقفها المعرفي أمام أي تحليلٍ مفهوميٍّ، أو قراءةٍ تاريخيةٍ، للظاهرة المدروسة أو لا تعي تلك الهشاشة. ولا تتضمّن (معظم) هذه الأبحاث أيّ مفهوم وصفيّ وتحليليّ، أو أيّ تحليل أو تدقيق مفاهيميّ، في تناولها للظاهرة المعنيّة، يمكن أن يبيّن، بعيدًا عن أي عملية ملأكةٍ أو شيطنةٍ، أن الحداثة حداثاتٌ، والدين أو الإسلام (السياسي) أديانٌ أو إسلاماتٌ (سياسية)، وأن ليس هناك علاقةٌ جوهرانيةٌ أو ماهويةٌ بين الطرفين. فالتشابك، الجزئي والنسبي، بين الديني والسياسي، ليس أمرًا سيّئًا بالضرورة، ولا مضادًّا لـ “الحداثة (السياسية)” بالضرورة؛ وأن علاقات المواطنة لا تقتضي، بالضرورة، الفصل، فصلًا كاملًا، بين المجالين الديني والسياسي. فالتشابك، الجزئي بالتأكيد، بين الدين والدولة، ما زال قائمًا في إنجلترا/ بريطانيا، وكذلك حالُ التشابك بين الدين والسياسة والدولة في ألمانيا، من دون أن ينفي ذلك وجود “حداثة سياسية” في هذين البلدين. والحديث بأن الحداثة تقتضي، بالضرورة، العلمنة التي توجب، بالضرورة، عدم توظيف الدين في السياسة، وفض التشابك بينهما، يفتقر إلى ما يسوِّغه معرفيًّا. ويبدو ذلك الافتقار واضحًا، إذا أخذنا في الحسبان الانتقادات الشديدة التي وُجِّهت، في العقود الخمسة الأخيرة خصوصًا، إلى نظرية أو نظريات العلمنة القديمة التي كانت تتبنى مثل ذلك الطرح، وتروِّج له، لكنها أصبحت مهجورةً عمومًا، في العلوم الاجتماعية المعاصرة عمومًا، وفي علم اجتماع الدين خصوصًا، خلال العقود القليلة الماضية ([4]).
يؤثِّر هذا التناول الأيديولوجي/ المعياري سلبًا في المضمون المعرفي لبعض نصوص المجلة، ويطبعها بأحاديةٍ اختزاليةٍ غير مسوَّغةٍ معرفيًّا، وقد تكون غير مفيدةٍ ولا مناسبة، أيديولوجيًّا وسياسيًّا أيضًا. ويقدم بحث “الإخوان المسلمون في سورية من الاستقلال حتى السبعينيات: النشأة، التوجهات والتحولات” نموذجًا لإمكانية التمييز بين “الإسلامات السياسية” المختلفة، واختلاف ماهية علاقاتها مع “الحداثة السياسية” المتمثلة في مفاهيم الديمقراطية والمواطنة ومنظومة حقوق الإنسان الحديثة.. إلخ. فهذا البحث يميز بين إسلامَين سياسيين مختلفين للإخوان المسلمين: “الإسلام السياسي لمصطفى السباعي”، والإسلام السياسي، أو بالأحرى الجهادي، عند سعيد حوى”. وفي حين أن الإسلام الأول إصلاحيٌّ واشتراكيٌّ، ويرفض حكم رجال الدين، و«مدني علماني، يصنع القوانين للناس على أساس من مصلحتهم وكرامتهم وسعادتهم، لا فرق بين أديانهم ولغاتهم» (ص 55)، كما يقول صاحبه مصطفى السباعي، فإن الإسلام الثاني “لا يعترف بالسلطة التشريعية والاجتهادية للبشر”، كما يفعل السباعي، ويقوم على «نظرية تيوقراطية للدولة، يكون فيها “الإمام” حاكمًا “تيوقراطي” لا يستمدّ سلطانه من الجماعة بل من الله» (ص 62). وعلى هذا الأساس يبدو أن الإنصاف المعرفي لا يسمح بالحديث عن “الموقف الأصيل” للإخوان المسلمين (ص 245)، بوصفه موقفًا أحاديًّا ومتطابقًا بالضرورة مع إسلامٍ جهاديٍّ متطرفٍ. فالبحث الثاني يبين تعدد المواقف التي يمكن وصفها بالأصالة، في هذا الخصوص، ويشدد، مع “يثرب الجديدة” لجمال باروت ([5])، على أن العلاقة، بين “الخطاب الإخواني الذي تبناه مصطفى السباعي” و”الخطاب الجهادي الذي تبناه سعيد حوى”، «تقوم على آلية “القطيعة” المعرفية، لا على آلية “التداخل النصي. فالخطاب الذي يقدمه حوى في كتاب (جند الله) لا يتأسس مرجعيًا على خطاب السباعي في كتاب (اشتراكية الإسلام)، وليس امتدادًا له، بل يتأسس على مرجعية جديدة» (ص 62).
انطلاقًا من ذلك، ومن غيره، نرى ضرورة الانطلاق من مفاهيم وصفيةٍ أو تحليليةٍ للظاهرة المعنيّة، تشمل أكبر عددٍ ممكنٍ من تجلياتها ومظاهرها وأنواعها، وتأخذ في الحسبان مختلف أشكال تمايزها الفعلية أو الممكنة، بدلًا من الانطلاق من مفاهيم معياريةٍ أحاديةٍ تختزل الظاهرة في جانبٍ من جوانبها الفعلية أو الممكنة. ويمكن المحاجة بافتقار الملف إلى أساسٍ/ تأسيسٍ نظريّ، وصفيّ وتحليليّ، يوضح طبيعة الإشكالية التي يتناولها، قبل أن يتخذ موقفًا معياريًّا من الظواهر/ الأطراف التي تتضمنها، حيث يستند ذلك الموقف المعياري إلى ذلك الأساس الوصفي والتحليلي، بدلًا من أن يتضمن ما يتناقض معه. ونرى أنه كان يمكن، وينبغي لمثل ذلك الأساس/ التأسيس النظري المفتقَد، إظهار مدى الترابط العضوي والتكامل بين الأبحاث التي يتضمنها، من خلال صياغة إشكاليةٍ محددةٍ واضحة المعالم، تمثل الأبحاث أطروحاتٍ مختلفةً ومتكاملةً، للإجابة عن الأسئلة الرئيسة التي تتضمنها. كما كان يمكن وينبغي لكلمة العدد، بوصفها تقديمًا لأبحاث ملف هذا العدد، وعرضًا لأهم مضامين تلك الأبحاث ونتائجها، أن تتضمن ضبطًا معرفيًّا، وصفيًّا ومعياريًّا، لعددٍ من أهم المفاهيم المستخدمة: الحداثة، الإسلام (السياسي أو الجهادي)، العلمانية …إلخ، وعرضًا للأسس النظرية التي تجمع وتميِّز بين الحداثات المختلفة والإسلامات المختلفة، والعلمانيات المختلفة.. إلخ، ونقاشًا للخلاصات النظرية التي يمكن استخلاصها وإبرازها من بحوث ذلك الملف. لكن تلك المقدمة اقتصرت على تبني الموقف الأيديولوجي السياسي المذكور، وعلى عرضٍ مقتضبٍ لتلك الأبحاث، مع تخصيص نصف صفحةٍ تقريبًا فقط، للحديث عن بعض النتائج التي يمكن استخلاصها من تلك الأبحاث. وعلى هذا الأساس؛ يمكن القول بوجود تأثيرٍ سلبيٍّ للسياسة/ الأيديولوجيا في الثقافة/ المعرفة، في السياق المذكور.
وتزداد ضرورة ضبط مفهوم “الإسلام السياسي”، حين نعلم أن الملف يتضمن القول بأن الإسلام السياسي لا يتمثل في ذلك الإسلام الذي يربط بين الإسلام والسياسة فحسب، بل يتمثل، أيضًا، في الإسلام الذي يقيم فصلًا حادًّا بين السياسة والدين، كما هي حال “إسلام الدعاة” و”إسلام القبيسيات”، بدعوى أن هذا الفصل هو نفسه عملٌ سياسيٌّ. (ص 11، 69) فإذا كان فصل الإسلام، أو ربطه، بين الدين والسياسة، يمكن أن يجعل منه إسلامًا سياسيًّا بالضرورة، فهذا يعني ضرورة الكف عن الإدانة المبدئية لـ “سياسية الإسلام”، وعن المطالبة بألا يكون الإسلام إسلامًا سياسيًّا. فما هو مطلوبٌ معرفيًّا/ ثقافيًّا، وأيديولوجيًّا/ سياسيًّا، هو التمييز المفاهيمي، الوصفي والمعياري، أو إظهار التمايزات، بين الإسلامات (السياسية) الموجودة بالفعل، أو التي يمكن أن توجد، من حيث المبدأ.
إن تناول الظواهر المدروسة، من خلال ثنائيةٍ مانويةٍ معياريةٍ، قد يكون أحد أعراض الواقع المأزوم، أكثر من كونه خطوةً معرفيةً مناسبةً في الطريق إلى فهم ذلك الواقع، دع جانبًا إمكانية المساعدة في تجاوزه، عمليًّا أو حتى نظريًّا. وهكذا نجد أنفسنا أمام مثنوياتٍ أو ثنائياتٍ إقصائيةٍ تتبنى، تبنيًّا حرفيًّا أو مقلوبًا، عمليات الاختزال والإقصاء التي يبدو، لوهلةٍ أو أكثر، أنها تقتصر على دراستها وبلورة موقفٍ مناهضٍ لها. وترتفع، في بعض نصوص الملف، الراياتُ الأيديولوجية التي ترى في طرفٍ ما “المشكلة”، وفي ما يناقض ذلك الطرف “الحلّ”، بدون وجود تدرجٍ أو منطقةٍ وسطى “ما بين الجنة/ النور والجهنم/ النار”. وما يجده أحد النصوص أو الأبحاث “الجنة أو النور” هو عينه ما يراه بحثٌ آخر “الجهنم أو النار”. ويبدو ذلك واضحًا في التقابل بين الاتجاه الحداثوي العلمانوي والاتجاه الإسلاموي، وشعاراتهما، المعلنة أو المضمرة، بأن أحدهما يمثل الحل فقط، والآخر يمثل المشكلة فقط.
وإذا كان نصّا “كلمة العدد” و” إشكالية التوظيف السياسي للدين …” يشيران، صراحةً أو ضمنًا، إلى أن “الحداثة أو العلمانية هي الحل أو المدخل الضروري للحل”، وأن الإسلام السياسي لا يمكن أن يكون إلا مشكلة، بل كارثة (كبيرة)، فقط وبالضرورة (ص 9-10، 263-264)؛ فإن بحث “التصوف وأثره في الجزيرة السورية” يتبنى موقفًا إسلامويًّا مناقضًا للموقف العلمانوي والحداثوي من تلك الثنائية المانوية، حيث يتحدث عن النصارى والعلمانيين والشيوعيين من أبناء منطقة الجزيرة على أنهم “أعداء الإسلام”، ويستعيذ “استعاذةً حرفيةً” بالله من “الإلحاد والكفر الصريح” لهؤلاء “العلمانيين والشيوعيين” (ص 230).
وعلى الرغم من أن بحث “الدين والدولة وسؤال المأسسة: وزارة الأوقاف السورية أنموذجًا” يتناول توظيف الدولة أو النظام “البعثي-الاستبدادي” لوزارة الأوقاف، “وتحويله لها إلى أهم أداةٍ من أدوات تسلط النظام”، بغية إنتاج إسلامٍ “وفق مسطرته” (ص 349)، فإنه لم يقاوم التوجه العلمانوي الثقافوي الذي ينظر إلى الإسلام، أو إلى الأصولية المرتبطة به، على أنها أسُّ أو أصل المشاكل، وارتأى ضرورة تكرار أطروحةٍ من أطروحات الثقافوية العلمانوية، في هذا البحث، تتمثل في أن الأيديولوجية القومية للبعث لم تقضِ على الأصولية الإسلامية، ولم تسعَ إلى ذلك أصلًا، وأنها لا تسعى إلى تقديم بدائل منها. فالبعث أو توجهه الأيديولوجي هو بالأصل جزء من المناخ الثقافي والسياسي المستطيل للأصولية الإسلامية في التاريخ المشرقي (ص 362).
تتضمن البحوث المنشورة في الملف عددًا كبيرًا من المثنويات الأيديولوجية المماثلة، وسنشير في الفقرات التالية إلى عددٍ من الأمثلة الموضِّحة لها.
3- في اتساع مساحة البحث وتأثير ذلك في مضامينه
يهدف الملف إلى تناول مسألة التفاعل بين الدين والمجتمع في سورية خلال المئة عامٍ الأخيرة. وقد أثر ذلك الطموح الكبير سلبًا في مستوى بعض أبحاث الملف. فعلى سبيل المثال، يتضمن البحث الأول، المعنون ﺑ “الجمعيات الإسلامية ودورها الاجتماعي والسياسي في سورية”، عرضًا لتاريخ تلك الجمعيات، خلال أكثر من قرنٍ من الزمن، “من بداية القرن العشرين حتى ثورة 2011” (ص 19). وقد أفضت محاولة البحث تغطية تلك الفترة الطويلة إلى اقتصاره غالبًا، على الأقل، على عرض معلوماتٍ عامةٍ لا تقدم أي إضافةٍ معرفيةٍ “مهمةٍ” غالبًا، وعلى أن يكون مجرد وصفٍ عامٍّ وتحليلٍ بسيطٍ لا يخلو من التبسيط والأحادية في كثيرٍ من الأحيان، ومن دون وجود محاولات تركيبٍ أو بناءٍ نقديةٍ (مهمةٍ).
يقدم تناول ذلك البحث ﻟ “الإخوان المسلمين” أنموذجًا توضيحيًّا للعمومية التبسيطية لذلك التناول. فقد اقتصر البحث على تناول “الإخوان المسلمين” في صفحةٍ ونصف الصفحة تقريبًا، وقدم معلوماتٍ عامةً عنهم، وعن تاريخهم، وتاريخ نشاطهم في سورية. فمثلًا، يتضمن البحث ذكرًا لمجزرة حماة 1982، لكنه يتحدث عن “الإخوان”، بوصفهم ضحايا فقط، من دون أي إشارةٍ إلى أي “خطايا”، أو حتى أخطاء، قاموا بارتكابها آنذاك. ونعتقد أنه لم يكن بمقدور البحث الدخول في تلك التفصيلات المهمة، لأنه كان مشغولًا بتغطية تلك الحقبة الواسعة جدًّا، بطريقةٍ فرضت عليه التناول العام، بعيدًا عن التفاصيل، والسطحي، بعيدًا عن أي محاولةٍ للتعمق، وبالوصف والتحليل فقط، بعيدًا عن التناول النقدي والبنائي أو التركيبي.
قد لا تكون تلك الأحادية في تناول “الإخوان المسلمين”، بوصفهم ضحايا (فقط)، عند الحديث عن مجزرة حماة، ناتجةً عن الاضطرار إلى التناول العام، فقط، بل قد تكون ناتجةً عن بعدٍ أيديولوجيٍّ/ سياسيٍّ/ ذاتيٍّ، أيضًا. ويبدو ذلك البعد واضحًا، وضوحًا كبيرًا، حين يقوّم البحث عمل تلك الجمعيات، فيرى أنها قد «نجحت في التأثير الاجتماعي وحفظ هوية المجتمع المحافظة، و[…] تحريك الشارع لإلغاء قوانين وإقرار أخرى انطلاقًا من رؤية دينية إسلامية» (ص 36). لكن هل “الحفاظ على الهوية المحافظة” نجاحٌ بالضرورة؟ قد يكون ذلك نجاحًا من منظورِ تلك الجمعيات، ومن منظور ذلك البحث، لكنه ليس بالضرورة كذلك من منظوراتٍ أخرى. ويُظهر هذ التقويم تبني الباحثة، صراحةً أو ضمنًا، للرؤية الدينية الإسلامية التي تدرسها. وهذا التبني ليس أمرًا سلبيًّا، بالضرورة، لكنه قد يكون، في المجال البحثي، أحد عوامل التناول الأحادي/ الأيديولوجي الذي سبق ذكره. ويتعزز الانطباع بوجود تلك الأحادية، حين يتم الاقتصار على تبني مثل ذلك المنظور الأيديولوجي، من دون تقديم أي محاجةٍ تسنده، ومع غياب أو تغييب المنظورات الأيديولوجية الأخرى.
وتزداد السلبية المعرفية لتناول “الإخوان المسلمين” بهذه الطريقة العامة المبسَّطة، لكون البحث الثاني من الملف مختصًّا بتناول “الإخوان المسلمين” تحديدًا. ونعتقد أنه كان ينبغي للبحث الأول أن يركز جهوده على مسائل أخرى، غير مسألة “الإخوان المسلمين”، ما دام البحث الثاني يتناول، بتفصيلٍ وتعمقٍ أكبر، هذه المسألة، وما دامت المعلومات التي يقدمها البحث الأول، في هذا الخصوص، لا تقدم أي إضافةٍ غير موجودةٍ في البحث الثاني. ويقع البحث الثاني في مطبٍّ مختلفٍ ومماثلٍ، في الوقت نفسه، للمطب الذي وقع فيه البحث الأول. ويتجلى ذلك المطب في تخصيص البحث الثاني أكثر من ثلاث صفحاتٍ للحديث عن “الجمعيات الإسلامية”، على الرغم من أن البحث الأول مخصصٌ بالكامل للحديث عن تلك الجمعيات، من دون أن يقدم البحث الثاني ما يسوِّغ تكراره لتلك المعلومات (ص 42-45).
وتَبرُز مسألة الاتساع الزائد للمساحة المطلوب من البحث تغطيتها، والمبالغة في حجم المهمّات الموكلة إلى البحث، في عددٍ من الأبحاث الأخرى؛ نذكر منها، على سبيل المثال، بحث “مدخل إلى دراسة التوريث الديني في سورية المعاصرة”، وبحث “العلاقة بين الدين والفن خلال مئة عام من التاريخ السوري”. لكن بعض هذه البحوث تتبنى طرقًا مختلفةً في التعامل مع تلك “المشكلة” و/ أو تجاوزها، أو التخفيف من آثارها السلبية قدر المستطاع.
ويتجاوز بحث “التوريث الديني” تلك المشكلة، من خلال إجراءين منهجيين. من ناحيةٍ أولى، يتضمن البحث اعترافًا واضحًا وصريحًا بالمشكلة: «كما هو واضح من عنوان البحث فإنّ مجال الدراسة فيه واسع جدًا، لأنّه يتناول الأديان المختلفة وفرقها العديدة في سورية، […]» (ص 240). كما يتضمن البحث، من ناحيةٍ ثانيةٍ، خفضًا صريحًا للسقف الذي ينبغي للتوقعات التي يمكن أو ينبغي للقارئ أن يتبناها في خصوص ذلك البحث: «لن يستقصي البحث الإجابة عن جميع هذه الأسئلة، ولن يحيط بالأديان وفرقها جميعها، ولا الأسر الدينية جميعها على اختلاف صنوفها، وسنكتفي بذكر أمثلة على سبيل الإلماح والمقاربة المجملة» (ص 240). ويبدو لنا أن البحث قد قدم أكثر مما زعم تقديمه. فلم يقتصر البحث على أن يقدم “مجرد لمحاتٍ خاطفةٍ”، كما نصت خاتمته. (ص 527) ويبدو لنا أن سمة التواضع قد تغلبت، في ذلك السياق، على سمة الموضوعية والدقة المعرفية. لكن البحث يترك كثيرًا من الأسئلة المهمة والأساسية معلقةً، ومن بينها السؤال المتعلق بمدى كون الظاهرة التي يدرسها ظاهرةً مهمةً فعلًا، ولها دلالاتٌ وأبعادٌ مهمةٌ فعلًا، تجعلها مختلفةً عن ظاهرة التوريث المهني السائدة في كثيرٍ من المهن والحالات والسياقات. وفي كل الأحوال، استطاع البحث أن يقدم مدخلًا معرفيًّا مهمًّا، وأساسًّا أوليًّا واعدًا، بدون وجود أو تقديم أي ضمانٍ بأن الموضوع سيسمح بالإيفاء بتلك الوعود، في حال توفر الجهود الذاتية المطلوبة.
وفي البحث الثاني، بحث “العلاقة بين الدين والفن خلال مئة عام من التاريخ السوري”، يتم تجاوز تلك المشكلة من خلال اللجوء إلى حلٍّ معقولٍ ومناسبٍ لموضوع البحث. ويتمثل ذلك الحل في شرح “العلاقة بين الدين والفن خلال مئة عام من التاريخ السوري”، عن طريق دراسة «هذه العلاقة من خلال ثلاث مراحل حضارية مختلفة، تتناول ثلاثة أنواع مختلفة من الفنون: المرحلة الأولى: ظهور اللوحة الحديثة والجدل الديني المرافق له. المرحلة الثانية: دور الدين خلال نشأة المسرح في سورية. المرحلة الثالثة: علاقة تنظيم الدولة الإسلامية داعش وفنون الموسيقى والغناء». (ص 404) وعلى الرغم من شيوع مثل تلك الطريقة في قراءة التاريخ والفترات الزمنية الطويلة لظاهرةٍ أو موضوعٍ ما، ومعقولية تلك الطريقة وإيجابياتها الكبيرة والكثيرة عمومًا، فإن تطبيقها قد يتضمن اختزالات غير مناسبة معرفيًّا، بحيث يفضي ذلك إلى إفقار المعرفة الناتجة عن تبني تلك الطريقة.
4- التوجه الدعوي في الإطار المعرفي/ البحثي
نجد، في عددٍ من الأبحاث، “نفَسًا دعويًّا” يتفاعل مع ممثلي الظاهرة المدروسة، ويتوجه إليهم بخطابٍ ودعوةٍ إلى فعل أمرٍ ما أو الامتناع عن فعل أمرٍ آخر. فعلى سبيل المثال، تتضمن خاتمة بحث “في أسباب الحضور الباهت للتديّن الدعوي في الثورة السورية” مطالبة رجالات الإسلام الدعوي في سورية، صراحةً، «بإعادة حساباتهم بشكل جذري، وتشجيع الناس على طلب حقوقهم من الحكام ولو بالقوة، ونبذ الفتاوى التي تنافق للأنظمة، والتخلي عن الجري وراء مصالحهم الشخصية والاستمتاع بالنجومية» (ص 86). وكذلك هي حال خاتمة بحث “القُبَيْسيّات” التي تتضمن مناشدة إحدى القُبَيْسيّات زميلاتها من ذوات النفوذ في الداخل: «يجب مراجعة مواقفكن الدعوية والسياسية، فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وكم من عابدٍ جاهل أشد خطرًا على الدين من إلحاد سافر صاخب؛ […].» (ص 136). وربما أمكن تسويغ مثل هذه الدعوات، أيديولوجيًّا، لكن قد لا يكون سهلًا أو ممكنًا تسويغها معرفيًّا، في مثل هذا السياق المعرفي/ البحثي. فمطالبة رجالات الدين الدعوي ﺑ “التخلي عن الجري وراء مصالحهم الشخصية والاستمتاع بالنجومية” تبدو تسجيلًا لموقفٍ أخلاقيٍّ/ سياسيٍّ وأيديولوجيٍّ منهم، أكثر من كونها دعوةً تبتغي فعلًا ما يبدو أنها تدعو إليه. وفي كل الأحوال، لا يبدو واضحًا السبب المستجد الذي قد يدفع “رجالات الدين الدعوي” المعنيين إلى الاستجابة إلى تلك المطالبة الأخلاقية/ السياسية.
يبيِّن هذا التزاوج بين الاتجاهين البحثي والدعوي أن عددًا من الباحثين يعون أنهم ليسوا في ميدان المعرفة المجردة فحسب، بل في ميدان الممارسة السياسية الأيديولوجية أيضًا، ولهذا رأينا عددًا منهم قد ذهبوا إلى حد الممارسة الواعية والصريحة لفاعليةٍ سياسيةٍ، تجعلهم، في نصوصهم، فاعلين سياسيين، إلى جانب كونهم باحثين معرفيين. وهذا هو أحد أوجه الجدل الذي تقيمه المجلة، أو تسعى إلى إقامته، بين الثقافة والسياسة. وإذا كان لهذا التوجه الدعوي إيجابيات ما، أو إذا لم يكن له سلبياتٌ واضحة ومؤكدة -كما الحال في المثالين السابقين- فثمة أمثلةٌ أخرى تبين بعضًا من السلبيات الفعلية و/ أو الممكنة لمثل ذلك التحيز السياسي/ الأيديولوجي للباحث.
يتضمن بحث “التصوف وأثره في الجزيرة السورية” ثنائيةً أيديولوجيةً تبسيطيةً لا تبدو مناسبةً، من أكثر من ناحيةٍ. فالبحث يتضمن أحكامًا معياريةً شديدة التحيز وقليلة الإنصاف من الناحيتين، المعرفية والأيديولوجية، في الوقت نفسه. فالبحث الذي يتحدث، كما أشرنا آنفًا، عن النصارى والعلمانيين والشيوعيين من أبناء منطقة الجزيرة، بوصفهم “أعداء الإسلام”، يتهم هؤلاء “الأعداء” بالسعي “إلى إبعاد المسلمين عن دينهم”، ويعبِّر عن أسفه لنجاحهم في مسعاهم إلى حدٍّ بعيدٍ، من خلال كونهم نجحوا في أن «ينزعوا الإيمان من قلوب كثير من الشباب، ويملؤوا تلك القلوب بالإلحاد والكفر الصريح، والعياذ بالله» (ص 230)، كما يتضمن البحث مفهومًا معياريًّا تقويميًّا، لا وصفيًّا تحليليًّا، للتصوف. وانطلاقًا من ذلك المفهوم، يتحدث البحث عن “نقاء التصوف” و”مكانه الحقيقي” (ص 235)، وعن “خروج التصوف عن مساره الصحيح” (ص 231)، وينتقد مبالغة «بعض الجهلة من المتصوفة في تقديس مشايخ طرقهم الصوفية لدرجة اعتقادهم بأن شيخهم [هو] المهدي المنتظر» (ص 229)، كما ينتقد شيوع «السفور بين عدد من بنات المسلمين، بسبب تشكيك أعداء الإسلام في الإسلام»، و«اعتناق كثير من الناس الشيوعية» (ص 231).. إلخ. وتكون (الأحادية) المعيارية واضحةً جدًّا في الخاتمة التي تتضمن دعوةً إلى «مضاعفة الجهد في مقاومة الأهواء والمصالح، ونبذ الأنانيات وحب الذات والإعجاب بها، وتقويم سلوك النفس وتهذيبها وتزكيتها على ضوء الكتاب والسنة، والاقتداء بسيرة السلف الصالح رحمهم الله تعالى» (ص 235). ويبدو هذا الخطاب الأخلاقوي أقرب إلى الخطاب الوعظي/ الأيديولوجي منه إلى الخطاب البحثي/ المعرفي.
إن مثل تلك المفردات والتعبيرات والجمل والأحكام المعيارية الواردة كثيرًا في ذلك النص، وفي بعض النصوص الأخرى، قد تكون غير مناسبةٍ، ولا مقبولةً، من المنظورين المعرفي، الموضوعي-المنهجي، والسياسي-الأيديولوجي، الذي تعلن المجلة تبنيها لهما، ومن أي منظورٍ يتقيد بالحدود الدنيا والشروط الأولية المطلوبة في البحث المعرفي “الرصين”. وفي كل الأحوال، من الضروري التفكير في مدى إمكانية الجمع، بين الدعوة الأيديولوجية والبحث المعرفي، في نصٍّ أو نتاجٍ أو توجهٍ فكريٍّ واحدٍ، وفي السلبيات والإيجابيات، الممكنة و/ أو الفعلية، لهذا الجمع، وفي مدى إمكانية تجنب تلك السلبيات، وتعزيز حضور تلك الإيجابيات، من حيث المبدأ، وفي كل حالةٍ على حدةٍ أيضًا. وإذا كان التفكير النظري المجرد قد أصبح يُنظر إليه، بحقٍّ حينًا، ومن دون حقٍّ أحيانًا اخرى، على أنه ترفٌ لا ينبغي، ولا يمكن، للعمل الثقافي أو الفكري في ميدان العلوم الاجتماعية، التركيز عليه والاكتفاء به؛ فمن الضروري التشديد، في المقابل، على أن المبالغة في التركيز على البعد العملي/ السياسي/ الأيديولوجي، والتسييس المفرط لفكرة الالتزام، يمكن أن تنتهي إلى “لغوٍ أيديولوجيٍّ”، كما أشار، مثلًا، عبد الإله بلقزيز، في كتابه المهم في هذا الخصوص “نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفين”([6]).
5- الخلط بين “ما هو كائنٌ” و”ما يجب أن يكون”
يبلغ التأثير السلبي للأيديولوجيا/ السياسة في المعرفة/ الثقافة، في أبحاث الملف، درجةً عاليةً، في بحث “الموحدون الدروز في سوريّة من 1920 إلى 2020″، حيث يتضمن ذلك البحث خلطًا كبيرًا بين الحديث عما هو كائنٌ، والحديث عما يجب أن يكون. وتتفاقم إشكالية هذا الخلط، وتزداد سلبياته، من وجهة نظر من يرى أن ما يتبناه البحث بوصفه “ما يجب أن يكون” هو تحديدًا ما يجب العمل على تفادي حصوله قدر المستطاع. وينطلق ذلك البحث من علاقات النسب والعقيدة التي تربط بين أعضاء “الموحدين الدروز” ليقول بأن لا خيار لهؤلاء الأعضاء إلا أن يكونوا أعضاءً في هذه الجماعة، وبأنهم لا يملكون إرادةً فرديةً حرةً في هذا الخصوص. ثم يشير البحث إلى أن الدروز، بوصفهم جماعةً، ينتمون إلى الدولة/ الوطنية السورية بالاختيار (315، 317). أما انتماء الأفراد الدروز إلى تلك الدولة/ الوطنية فليس مباشرًا، وإنما يمرّ عبر انتماء جماعتهم إليها. ولا يخفي البحث تبنيه للاتجاه الجماعاتي في هذا الخصوص، لكن البحث يحاول أن يجعل من النسب اللاإرادي أساسًا للانتماء الجماعاتي والسياسي، في حين أن الاتجاهات الجماعاتية الديمقراطية المعاصرة تشدد على ضرورة عدم المساس بحرية الأفراد، وعلى ضرورة تمتعهم بالقدرة على اختيار الانضمام أو عدم الانضمام إلى هذه الجماعة (غير) العضوية أو تلك. وهكذا يسعى البحث المذكور إلى تأسيس المصير على القدر، وإلى تأسيس ما هو مدنيٌّ، واختياريٌّ/ إراديٌّ، وسياسيٌّ على ما هو أهليٌّ ولا-اختياري/ لا-إرادي، ولا-سياسي.
وعلى الرغم من النظرة الجوهرانية التي يصر البحث على تبنيها، والدعوة إليها، في خصوص أولوية انتماء أعضاء الموحدين الدروز إلى جماعتهم، ومن ثم إلى الدولة/ الوطنية السورية عبر انتماء جماعتهم إليها، فإن البحث يقر بأنه، في بعض السياقات، «ازدادت منزلة الأفراد بوصفهم مواطنين على حساب الجماعة. فبدأ ولاؤهم ينزاح تجاه الدولة السوريّة كما بدأت سيرورة تحوّلهم إلى مواطنين…» (328)، وبأن هذا ما حصل بين 1970-2011. في المقابل، وفي تناقضٍ مع ما سبق، يصر البحث على أنه «حتى لو حصّل الفرد على حقوقه المتساوية مع غيره من الأفراد في المواطنة، فإنّ ولاءه يبقى لجماعته الطائفيّة وليس للمواطنة، كما يبقى شعوره بمظلوميّة جماعته متأججًا» (331). ومن الواضح تناقض ذلك الحكم الأخير ليس مع الرؤية التاريخية المفهومية والواقعية عمومًا فحسب، بل تناقضها أيضًا مع المعطيات التاريخية التي يتضمنها البحث ذاته الذي يتضمن القول بأنه و«مع “الحركة التصحيحية” بدأ تراجع دور العقيدة والقربى في ولاء الموحدين الدروز. واقتصر أمرُ القربى على صناديق العائلة وبعض الحساسيّات والمحسوبيّات، وأمرُ مشايخ العقل على التمجيد بحافظ الأسد. واستمر الوضع حتى قيام الثورة السورية 2011 […]» (ص 328).
ومن الناحية المعرفية “المحضة”، ليس واضحًا (كثيرًا) سبب امتناع البحث المذكور عن فحص تلك الإمكانية (انزياح ولاء عدد كبيرٍ من الدروز من الجماعة إلى الدولة)، واقتصاره عمومَا على التشديد على “قداسة” ولاء أعضاء الجماعة الدرزية لجماعتهم، وعلى خصوصية هذه الجماعة، والمطالبة بحقوقٍ جماعاتيةٍ خاصةٍ بها. ولا تقتصر الحقوق التي ينشدها البحث على الحقوق الثقافية فحسب، بل تتعداها إلى حقوقٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ (ص 328-329). ويرى البحث أن الدروز يشعرون بالغبن، ولا ينالون ما يستحقونه من حقوقٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ. ومعيار الاستحقاق، من وجهة نظر البحث، هو “تضحياتهم وولاؤهم وحيادهم” (ص 329). ويبدو أن العامل السياسي الأيديولوجي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الخصوص، أما الجانب المعرفي/ الثقافي فإن الكلمتين المذكورتين تضيقان عليه كثيرًا، وتؤثران فيه تأثيرًا سلبيًّا، عمومًا.
وهذا البحث من الأبحاث القليلة التي لا تقتصر على الوصف والتحليل، بل تتضمن طرحًا بنائيًّا أو تركيبيًا جديدًا. لكن مضمون الطرح والتناقضات المعرفية الكثيرة والكبيرة التي يتضمنها يبينان أن الجديد ليس أفضل من القديم بالضرورة، وأن الطرح البنائي الجديد قد يكون عودةً إلى الوراء، بالمعنى المعرفي على الأقل، أكثر من كونه خطوةً معرفيةً إيجابيةً. وإذا كان الهدم جزءًا مهمًّا وأساسيًّا من أي عملية بناءٍ، كما شدد هايدغر محقًّا، فإن بعض عمليات البناء “المزعومة” تبدو أقرب إلى الهدم المحض منها إلى البناء الفعلي.
ومن المفارقات الطريفة التي يتضمنها هذا البحث، سعيُه الكبير لإثبات خصوصية الجماعة الدرزية وتمايزها عن العرب والمسلمين والمسيحيين واليهود والبدو، من جهةٍ أولى (ص 317)، ثم القول بأن كل الجماعات المذهبية والطائفية الأخرى تتميز عن العرب والمسلمين إلخ، من جهةٍ أخرى. لكن السؤال هنا هو التالي: إذا كان العرب متمايزين عن المسلمين، من حيث إن “العرب يتميزون بقوميتهم، والمسلمين والمسيحيين واليهود يتميزون بدينهم”، وإذا كان العرب والمسلمون والمسيحيون واليهود متمايزين عن السنّة والشيعة والموحدين الدروز والإسماعيليّة والموارنة والكاثوليك الذين يتميزون بمذهبهم؛ فلن يكون للعربي ولا للمسلم ولا للمسيحي إلا وجود اسميّ أو نظريّ، لأن العربيّ هو مسلمٌ أو مسيحيٌّ نسَبًا على الأرجح، والمسلم والمسيحي ينتميان إلى هذه الطائفة أو تلك، أو هذا المذهب أو ذاك، وبانتمائهما الأخير يصبح العربي غير عربيٍّ، ويصبح المسلم غير مسلمٍ، أي يتمايز الشخص، بوصفه سنيًّا أو شيعيًّا، عن العربي والمسلم…!
هذا التحيز والمنظور الجماعاتي الضيق نجد ما يماثله، جزئيًّا ونسبيًّا، في البحث المعنون ﺑ “الإيزيدية: المكون الغائب من النسيج السوري”. فالبحث يتحدث من منظورٍ “جماعاتيٍّ إيزيديٍّ خالصٍ”، ويسعى بوضوحٍ إلى إبراز إيجابيات الإيزيديين، والرد على منتقديهم والمنتقصين منهم؛ فيشير مثلًا إلى أن الإيزيديين قد “حملوا السلاح إلى جانب المكونات الدينية والإثنية الأخرى لمحاربة الاستعمار الفرنسي” (ص 337)، وإلى أنهم «أثبتوا حيويتهم الوطنية والإنسانية، فكانوا في المقدمة في أثناء الحروب للدفاع عن الوطن السوري، هتفوا للثورة الجزائرية والفيتنامية، ولثورات التحرر الوطني كلها، قدموا الشهداء للمقاومة الفلسطينية واللبنانية إيمانًا منهم بأنها قضية عادلة، وبأن الحل الأمثل لتحرير أي شعب أو مكون صغير وإبراز خصوصيته يكمن في الديمقراطية والمواطنة […]» (ص 339). فما يسعى إليه البحث، بالدرجة الأولى، هو «تعزيز دور الإيزيدية في سورية ضمن الوحدة الوطنية، وإزالة الصورة النمطية من الأذهان، وترسيخ حقوق المكونات السورية كافة في الدستور» (ص 340-341).
يتضمن البحث كثيرًا من الكلام المعقول عن ضرورة «خلق أطر قانونية تحمي المكونات الأكثر ضعفًا» (ص 342)، و”الاهتمام بالمكونات السورية كافة في سورية على نحوٍ متساوٍ”. ما يثير كثيرًا من الاستغراب والانتقاد هو غياب أو تغييب أي حديث عن حالة (عدم) المساواة بين الأفراد داخل الجماعة الإيزيدية نفسها، وفقًا لرؤية دينيةٍ تقسم اليزيديين إلى (ثلاث) طبقاتٍ أو مستوياتٍ متراتبةٍ، وفقًا للنسب الموروث، ومغلقةٍ لا يمكن تغييرها والانتقال أو التزاوج فيما بينها. وفي هذه التراتبية، يحظى من هم في قمة التراتبية بميزاتٍ لا يحظى بها أفراد الطبقات أو المستويات الأخرى المطالَبين بالطاعة والتبعية والخضوع للشيوخ/ الأمراء بوصفهم القادة الدينيين للجماعة. ومن الواضح مدى عنصرية هذا التقسيم، الطبقي وتناقضه المفاهيمي الكبير مع كل مفاهيم المواطنة والمساواة الديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان المعاصرة. وفي ملفٍ يتحدث عن العلاقة بين الدين والمجتمع، يمكن للمرء أن يتوقع بحث مثل هذه المسائل الدينية/ المجتمعية. وليس مستبعدًا أن يكون البعد الأيديولوجي/ السياسي هو العامل الأهم الذي أفضى إلى سكوت ذلك البحث، وبحوثٍ أخرى في الملف، عن مثل هذه المسائل المهمة، في ذلك السياق، وأثر بذلك سلبًا في المضمون المعرفي/ الثقافي للملف المذكور.
6- في إيجابيات الاعتماد على الخبرة الحية والملاحظة بالمشاركة والفاعلين السياسيين ومحاذير ذلك الاعتماد وسلبياته
ثمة شحٌّ كبير في المصادر والمراجع التي تتناول الموضوع الذي يطرحه الملف على طاولة البحث. وقد تضمنت معظم الأبحاث تعبيرًا عن المعاناة في هذا الخصوص. فبحث “التصوف وأثره في الجزيرة السورية” يشير إلى “قلة المصادر المكتوبة والمدونة في الموضوع”، بوصفها “أهمّ العوائق التي حالت دون الوصول إلى المراد بشكله المطلوب” (ص 219). ويشير بحث “مدخل إلى دراسة التوريث الديني في سورية المعاصرة” إلى انعدام أو ندرة الأبحاث التي تناولت دراسة ظاهرة (الأسر الدينية في سورية)، وإلى مشكلة قلة الوثائق التاريخية التي يمكن أن يستند إليها الباحث (ص 238). ويشير بحث “العلويون في مهب السلطة” إلى غموض الجماعة الباطنية و”امتلاء تعريفها بالتخيلات والغرائب، ما يزيد في عزلها وانعزالها”، لأن الجماعات الباطنية لا تعرّف نفسها، وعليه تصبح معرفتها محكومة بروايات وملاحظات الغير (ص 281). والأمر ذاته تقريبًا مُشارٌ إليه في البحث عن “القُبَيْسيّات”، ﻓ “الجماعة لم تتحدث عن نفسها كتابة أو مشافهة، ومن هنا لا نستطيع أن نقطع بدقة المعلومات عنها” (ص 105). كما يشير البحث عن “الإيزيدية” إلى “الغموض الذي اكتنف تعاليمها، ما دفع مخيلة الآخر إلى نسج تصورات مغلوطة عنهم” وإلى «أن أحدًا من المدافعين عن الإيزيدية خلال السنوات [الأخيرة] لم يقدم منهجية علمية واضحة لإزالة الصورة النمطية الغامضة عنهم» (ص 335). ويشدد بحث “العقال والعمامة” على «قلة الدراسات التي تتناول توثيق الحياة الاجتماعية أو الثقافية للعشيرة السورية”، و”الافتقار إلى المصادر والمراجع الضرورية في هذا المجال”. ويسجِّل «حقيقة مؤلمة، هي أن أفضل ما كتب في هذا المضمار جاء على يد المستشرقين» (ص 87-88).
انطلاقًا مما سبق، يمكن فهم سبب لجوء عددٍ كبيرٍ نسبيًّا من الباحثين والكتّاب إلى الاعتماد «على منهج الرواية في نقل الأحداث من خلال أشخاص عاشوا الحدث» (ص 219)، أو على معلوماتٍ مباشرة استقاها الكاتب من بعض الشهود أو أصحاب، كالاعتماد، في بحث “القُبَيْسيّات”، على بعض طالبات كلية الشريعة المنتسبات إلى الجماعة (ص 105)، أو “على الملاحظة بالمشاركة المتبعة في الأنثربولوجيا” (ص 315)، … إلخ. حتى البحث الذي «فضّل العودة إلى المقالات والدراسات التي وثقت تلك الأحداث للتأكيد على الصدقية العلمية في الدراسة» (ص 292)، لم يقاوم إغراء التعبير عن «بعض الانطباعات الشخصية المعيشة من قبل (الكاتب) في المجتمع السلموني» (ص 313)، الذي قام بدراسته.
ولا شك أن للاستعانة بالمعايشة الشخصية و/ أو الخبرات الخاصة للباحث، أو لأشخاصٍ آخرين، بعض المزايا والإيجابيات، لكن لها أيضًا بعض المحاذير والسلبيات. ومن إيجابيات هذه المعرفة التماس المباشر مع الخبرة أو المعلومة، ومعرفة كثير من المسائل والمعلومات التي يصعب على “الغريب” الوصول إليها. وإن تحيز منظور الباحث أو الكاتب، وتبنيه لمنظور الجماعة التي يكتب عنها، يسمحان له بتكثيف منظور تلك الجماعة، وتقديمه، في أحد أقوى أشكاله ومضامينه الممكنة. ويمكن التخمين بأن هذا ما يمكن استشفافه في التكثيف التالي ﻟ “المنظور الإيزيدي الجماعاتي”: «الإيزيدية مهددة بالانقراض وفق الدستور السوري، ومتهمة من قبل الإسلام السياسي بالكفر والزندقة، ومحرفة من قبل القوميين الأكراد من الزرادشتية […]» (ص 346). في المقابل، الخبرات الفردية جزئيةٌ بالضرورة، وهي بالتالي خبراتٌ منظوريةٌ بالضرورة. وإضافة إلى هذا التحيز المنظوري، هناك التحيزات الأيديولوجية المرغوبة التي تحصل بتأثير الميل إلى طرفٍ ما، و/ أو النفور من طرفٍ آخر. ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا رأى بعض الفلاسفة، مثل سقراط ونيتشه، صعوبة أو استحالة معرفتنا المباشرة لذواتنا. فهذه المعرفة صعبةٌ، وقد تكون مستحيلةً، بسبب قربنا الشديد من ذواتنا. فحال هذه المعرفة كحال رؤيتنا لذواتنا في المرآة، فبدون مسافة فاصلة بيننا وبين تلك المرآة تستحيل تلك الرؤية. ولهذا السبب، رأى بعض الفلاسفة، كديلتاي وريكور، أن معرفة الإنسان لذاته تمر بالضرورة عبر معرفة الآخر، بمعنيي الإضافة هنا، أي من خلال المعرفة المتبادلة مع الآخرين: معرفتي للآخر ومعرفة الآخر لي. وبهذا المعنى، يبدو أننا في حاجةٍ دائمةٍ إلى “وسيط أجنبيٍّ يعرفنا بأنفسنا” (ص 158)، وتلك الحاجة ليست مستهجنةً بالضرورة. والاعتماد على “الدراسات الأجنبية/ الاستشراقية”، ليس سلبيًّا، بل له إيجابياتٌ كبيرةٌ وكثيرةٌ، ليس نادرًا أن يتم تجاهلها أو التقليل منها.
تفاوتَ حضور سلبيات ذلك الاعتماد المنهجي على الشهادات والخبرات الشخصية، وإيجابيات ذلك الاعتماد، في أبحاث الملف، ففي حين تكثفت، في بعض الأبحاث، معظم إيجابيات ذلك الاعتماد، كانت سلبيات تلك المنهج ذات حضورٍ قويٍّ في أبحاثٍ أخرى. وفي كثيرٍ من الأحيان، ازداد حضور السلبيات بازدياد اعتماد الباحث على منظوره الشخصي الخاص في إطلاق أحكامٍ عامةٍ وجازمةٍ، لا تسمح له خبراته ومعارفه وقدراته بإطلاق مثل تلك الأحكام.
ونجد في بحث “القُبَيْسيّات” بعض الأحكام البالغة السوء، معرفيًّا/ ثقافيًّا وأيديولوجيًّا/ سياسيًّا. فعلى سبيل المثال، يتحدث ذلك البحث عن الاتجاه النسوي بوصفه الاتجاه الذي «يجاهر بعدائه المسرف للرجل وشهوة الانتقام منه، من خلال إلغاء دور الأب في الأسرة والتمرد عليه ورفض الزواج والإنجاب […]» (ص 125)، كما يتحدث عن أن «المرأة الشرقية مهما بلغت في تحصيلها العلمي ودرجة ثقافتها؛ فإنها تعاني من قصور الرأي والرؤية تحت وطأة مجتمع ذكوري يعاملها بفوقية معرفية وحذر وعدم ثقة» (ص 125). هذه النظرة الازدرائية المشوَّهة والمشوِّهة، والدونية/ الفوقية، للاتجاه النسوي، وللمرأة الشرقية، عمومًا، تُظهر مدى خطورة الاستناد إلى الانطباعات والآراء والخبرات الشخصية والمنظورية، وتحويلها إلى تعميماتٍ وأحكامٍ جازمةٍ. والأمر ذاته تقريبًا يمكن قوله في خصوص الحكم المطلق والجازم الذي يتضمنه البحث ذاته والمتمثل في القول بأن “الوعي السليم لا ينمو إلا في جو من الحرية المطلقة” (ص 126)، فمن البديهي أو المسلّم به استحالة وجود حريةٍ مطلقةٍ. لكن هل يعني ذلك أن “الوعي السليم غير موجودٍ أو أنه لا ينمو؟ فمن الصعب جدًّا أخذ مثل ذلك الحكم على محمل الجد. ولا بد من أن الوعي الذي يتقبل، أو حتى يقبل، مثل تلك النتيجة المنطقية “غير المنطقية” و”غير المعقولة”، هو “وعيٌ غير سليمٍ” لا يمكن الاعتماد عليه.
وفي البحث ذاته، وفي معظم البحوث الأخرى، ثمة معلوماتٌ مقدمةٌ من دون توثيقٍ و/ أو إحالةٍ على مصدرٍ يسوِّغها، بالرغم من حاجتها المعرفية إلى مثل ذلك التوثيق و/ أو تلك الإحالة. ففي بحث “الصوفية في دمشق”، يتكرر الحديث عن أن موقف الشيخ أحمد كفتارو قد «تراوح بين الصمت أحيانًا، مبررًا ذلك بأنه يقوم بواجب النصيحة للحكام بالحكمة، وفي آذانهم وليس عبر وسائل الإعلام؛ وبين التأييد الواضح والعلني لسياسات السلطة القائمة» (ص 175)، بدون الاستناد إلى أي مرجعٍ أو مصدرٍ، أو توثيق أو اقتباس أي قولٍ لكفتارو، في هذا الخصوص. والتوثيق مطلوبٌ هنا، لأن البحث يشير إلى تأييد الشيخ كفتارو الواضح والعلني لسياسات السلطة القادمة.
وفي بحث “القُبَيْسيّات”، يُفسَّر وصف عبد الرزاق عيد للقبيسيات بـ “السحاقيات” بأنه حصل “تحت تأثير غلو علمانيٍّ” (ص 106)، من دون تقديم أي توضيحٍ أو تسويغٍ لهذا التفسير، سوى الإحالة على مقالٍ لعبد الرزاق عيد ([7])، مع أن تسويغ ذلك الحكم ليس واضحًا، انطلاقًا من مضمون ذلك المقال، أو من فكر عيد المتصل بهذه الفكرة عمومًا. ونزعم أنه لا يوجد قرائن قوية، في المقال المحال عليه، وفي نصوص عيد عمومًا، تتضمن مثل ذلك “الغلو العلماني”. وقد لا يكون ضروريًّا التشديد على أننا نرى أن حديث عيد عن القُبَيْسيّات بهذه الطريقة لم يكن لائقًا عمومًا.
وعلى الرغم من أن بحث “الإسماعيليون في سورية: مؤشرات الاندماج” قد «فضل العودة إلى المقالات والدراسات التي وثقت تلك الأحداث للتأكيد على الصدقية العلمية في الدراسة» (ص 292)، فإنه تضمن بعض الأحكام غير المسوغة معرفيًّا. ومن بين تلك الأحكام، القول الجازم بأنه «في بداية عام 2013 نفذ النظام بعض التفجيرات العسكرية في مدينة السلمية، لتحويل أنظار الإسماعيليين باتجاه الخطر الطائفي القادم من السنة، والدعوة للتطوع في ما يسمى جيش الدفاع الوطني لحماية السلمية» (ص 311). فلا يبدو أن المعطيات المتوفرة، أو التي يقدمها البحث، تسمح بالجزم في هذا الخصوص. ولهذا فإن “الصدقية العلمية للدراسة” قد تقتضي تخفيف درجة الجزم، ووضعها في صيغة التخمين والترجيح في “أحسن الأحوال”. والأمر ذاته ينطبق على تعميمٍ غير مسوَّغٍ معرفيًّا يتضمنه البحث ذاته. حيث جاء في “الانطباعات الشخصية المعيشة من قبل (الكاتب) في المجتمع السلموني”: «الإسماعيليون كافة لم ينتبهم شعور الأقلية في سورية تاريخيًا، بل تطلعوا وعملوا من أجل العيش مع بقية المكونات السورية كافة في دولة تقوم على معايير الحداثة والمواطنة، فهي الوحيدة الضامنة لمستقبل السوريين كافة» (ص 314). من المستبعد أن يكون هناك شخصٌ قادرٌ على تقديم مسوغات معرفية كافية لمثل هذا التعميم والحكم المطلق والجازم (الإسماعيليون كافة لم ينتبهم شعور الأقلية في سورية تاريخيًا)؟ ومن المستبعد وجود إمكانيةٍ فعليةٍ لأخذ المعنى الحرفي والدقيق لمثل هذا التعميم على محمل الجد، على الرغم من وجود صيغة التوكيد في الحكم.
تبلغ سلبيات مثل تلك الأحكام ذروتها، عندما يتم تقديمها على أنها حدوسٌ تؤسس لغيرها، بدون أن يكون واضحًا ماهية أسسها الخاصة، وعندما يكون هناك تناقضٌ غير جدليٍّ بين تلك الحدوس/ الأحكام. وهذا ما نراه، على سبيل المثال، في حكمين متناقضين، أحدهما موجود في بحث “العلويون في مهب السلطة السياسية”، والآخر موجودٌ في البحث عن “الإيزيدية”. ففي البحث الأول نجد جزمًا بأن كل جماعةٍ مذهبيةٍ «تحمل ميلًا إلى السيطرة، [… وأن هذا الميل] موجود بالتأكيد بوصفه طموحًا طبيعيًا أو غريزيًا لدى الجماعات». ولا يتضمن البحث أي محاولةٍ للتدليل على صحة هذه الأطروحة، على الرغم من كونها إحدى (أهم) الأطروحات التي يتأسس عليها البنيان المعرفي للبحث كله. وفي مقابل هذا الحكم الحدسي، نجد حكمًا حدسيًّا آخر ومناقضًا للحكم الأول، ويتمثل في القول: «لا تسعى الإيزيدية إلى السلطة، ولا إلى الغزو وبسط نفوذها على المناطق واسعة، ولا إلى إكراه مجموعات بشرية على اعتناق الديانة الإيزيدية. […] وليس في مقدورها تأسيس خطاب يدعو الى العنف والكراهية أو الترويج لهما. ومن ثم، تقوم الديانة الإيزيدية على مبادئ التسامح والتعايش واحترام الآخر ونبذ العنف والإكراه بين مكونات الشعب السوري جميعها ضمن القوانين السورية» (ص 346).
المشكلة التي نواجهها معرفيًا، في خصوص مثل هذه الاحكام المعيارية العامة والجازمة، تكمن، من ناحيةٍ أولى، في افتقارها إلى محاجاتٍ تسندها، وتسمح بمناقشة الحجج التي (ينبغي أن) تقدمها، وتفضي إلى توفير ما يسمح بقبولها أو رفضها والاختلاف معها، معرفيًّا؛ وتكمن، من ناحيةٍ ثانيةٍ، في استنادها، غالبًا، بوعيٍ أو من دون وعي، إلى رؤيةٍ جوهرانيةٍ أو ماهويةٍ للجماعات تفترض وجود غريزةٍ أو طبيعةٍ ثابتةٍ أو جامدةٍ للجماعات، ولا تأخذ، في الحسبان، التأثيرات القوية والمختلفة للسياقات التاريخية المختلفة. فعدم وجود ميلٍ إلى السيطرة لدى الجماعة الإيزيدية ليس ناتجًا عن طبيعة أو ماهية خاصةٍ بها، كما يقول البحث عن “الإيزيدية”، وإنما هو مرتبطٌ بحجم هذه “الجماعة”، وبقوتها وبقدراتها وبالعديد من العوامل المؤثرة في السياق التاريخي الذي توجد فيه. ولهذا يبدو أن “الطبيعي” أو “الغريزي”، في هذا السياق، لا يكمن، على الأرجح، في أن يكون لديها ميلٌ إلى السيطرة، بل يكمن تحديدًا في أن يكون لديها ميلٌ إلى رفض امتلاك أي جماعةٍ ميلًا إلى السيطرة.
ومن التحديات التي تواجه الاستناد إلى الخبرة الخاصة، والمعايشة الشخصية للظواهر المبحوثة، في دراسة أحداثٍ أو كياناتٍ أو ظواهر تاريخيةٍ متعينةٍ، تحدي التنظير لتلك الظواهر، أي إطلاق أحكامٍ عامةٍ، مع تجنب خطر الانزلاق إلى تبني نظرة ماهويةٍ أو جوهرانيةٍ، في الحديث عن الجماعات العضوية أو الأطراف الاجتماعية/ السياسية الأيديولوجية المختلفة. الابتعاد عن تخثير أو تجميد (دم) التاريخ في ماهيات أو جواهر لا-تاريخية ليس أمرًا سهلًا على من يحاول الكشف عما هو عابرٌ للتاريخ في دراسته للتاريخ. ولم تكن مواجهة أبحاث الملف لهذا التحدي سهلةً أو ناجحةً دائمًا، لأسبابٍ كثيرةٍ، يتعلق بعضها بالتخندق الأيديولوجي الناتج عن، و/ أو المفضي إلى، ضيق المنظور المعرفي المتبنى وهيمنة الأحكام المعيارية المسبقة والنظرة الأحادية الاختزالية. وقد ظهر ذلك المنظور، وبرزت تلك النظرة والأحكام، بدرجاتٍ متفاوتةٍ، في خطاب بعض نصوص الملف عن مسائل الحداثة والعلمانية والإسلام السياسي، أو عن بعض الجماعات العضوية، كالدرزية والإيزيدية والإسماعيلية والعلوية.. إلخ.
7- في بعض المسائل المنهجية واللغوية (و)”الشكلية” المهمة
ما سبق ذكره حتى الآن يتعلق بمضمون العدد المزدوج عمومًا، وبمضمون ملفه عن “الدين والمجتمع” خصوصًا، ومن منظورٍّ جزئيٍّ ونسبيٍّ محددٍ. وسأحاول، في ما يلي، مناقشة بعض القضايا المنهجية واللغوية التي تتعلق ببنية الأبحاث ولغتها وصياغتها وتوثيقها وإخراجها الفني.. إلخ. وعلى الرغم مما قد يبدو من شكلية أو حتى شكلانية بعض أو معظم تلك القضايا، فثمة معقوليةٌ كبيرةٌ في الزعم بالأثر الكبير لتلك “القضايا الشكلية” في مضمون تلك الأبحاث وتلقي هذا المضمون. وسأحاول، في ما يلي، إظهار تلك المعقولية “المزعومة”.
1) في البنية المنهجية للأبحاث
ثمة اختلافٌ كبيرٌ بين البنى المنهجية للأبحاث المنشورة في المجلة عمومًا، ومنها الأبحاث المنشورة ضمن الملف. ويحيل مفهوم البنية المنهجية، في هذا السياق، على (العلاقة المتبادلة بين) العناصر التالية، تحديدًا أو خصوصًا: 1- الموضوع الذي يتناوله البحث، و2- الإشكالية الأساسية التي يود معالجته في خصوص ذلك الموضوع. والمقصود بالإشكالية هو السؤال الرئيس الذي يحاول البحث الإجابة عنه وتناوله، من خلال تبني أطروحةٍ من بين عدة أطروحاتٍ ممكنةٍ ومتعارضةٍ، في الوقت نفسه، و3- الأسئلة الفرعية المتفرعة عن السؤال الأساسي لتلك الإشكالية، و4 -الأطروحة التي تتبناها في خصوص تلك الإشكالية و5- الحجج والأدوات المنهجية التي تتبناها أو تستخدمها للتدليل على صحة تلك الأطروحة أو إظهار معقوليتها وموضوعيتها. ولا ينبغي لكل نصٍّ بحثيٍّ أن يتضمن، بالضرورة، ذكرًا مفصَّلًا ومنفصلًا لكل عنصرٍ من تلك العناصر، إذ يمكن لتلك العناصر أن تتشابك، فيظهر الموضوع من خلال الحديث عن الإشكالية، و/ أو تتضح ماهية الأسئلة الفرعية من خلال تحديد السؤال الأساسي/ الإشكالية، و/ أو يبدو مفهومًا ماهية المحاجة المستخدمة من خلال الحديث عن الأطروحة التي يتبناها البحث.
ويمكن التمييز بين نمطين مثاليين، بالمعنى الفيبري، أساسيين للنصوص البحثية والبنى المنهجية لتلك النصوص: نمط التأمل والتسلسل الزمني الخطي، ونمط المنهجية الصارمة والبدء من النهاية.
في نمط التأمل، يمكن لبداية البحث أن تتضمن عرضًا أو إلماحًا لمسألةٍ إشكاليةٍ، ولبعض الخلفيات التاريخية، والأسس المعرفية، لتلك المسألة، ومن ثم يتدرج البحث في عرض المشكلة ومناقشة الأطروحات المختلفة الموجودة أو التي يمكن أن توجد، للمفاضلة فيما بينها من خلال محاجةٍ تتضح في نهايتها فقط، تقريبًا، الأطروحة التي يتبناها الكاتب، ووجهة نظره عمومًا في خصوص الإشكالية والأطروحات المختلفة في خصوصها. في هذا النمط، يبدو وكأن الباحث يفكر (من) خلال الكتابة، ويعبِّر عما يجري أو “يصول ويجول” في فكره فعلًا، مع وجود انفتاحٍ دائمٍ وآفاقٍ متعددةٍ لا يمكن التكهن او الجزم تمامًا بما سيحدث لها لاحقًا. النص البحثي هنا أشبه بالرواية التقليدية التي تحاكي السيرورة الخطية للزمن من الماضي إلى المستقبل عبر الحاضر. وعلى الرغم من تقليدية تلك السيرورة، بل بسبب تلك التقليدية، يكون هذا النمط من البحوث أكثر تشويقًا، وأقل اصطناعًا، من بحوث النمط الثاني. ويمكن القول إن بحث “العلويون في مهب السلطة السياسية” (ص 281-290) من أقرب أبحاث الملف التي تتبنى ذلك النمط التأملي.
النمط الثاني من البحوث يكون ذا بنيةٍ أكثر انضباطًا وتحديدًا ووضوحًا. ففي هذا النمط، يحدد الباحث، منذ البداية، النتائج التي توصل إليها، بوصفها الأطروحة التي سيحاول إثباتها في خصوص إشكاليةٍ ما يعرض ملامحها، ويبين مضمون تلك الإشكالية والطريق الذي سيسلكه في تناولها، وفي التدليل على الأطروحة التي يتبناها في خصوصها. ويسود هذا النمط “الأنجلوسكسوني” من البحوث في المجال الأكاديمي (“الغربي”)، أكثر فأكثر، في حين يبقى النمط التأملي حاضرًا بقوة في أعمال الفكر التأملي والفلسفي عمومًا، وذاك الذي يتناول إشكالياتٍ وأفكارًا عامةً، لا إشكالياتٍ ومسائل جزئيةً و/ أو متعينةً، خصوصًا. ففي النمط التأملي من النصوص أو الأبحاث، يتساوق إنتاج النص مع إنتاج الفكر، جزئيًّا على الأقل، ولا يكون النص، أو لا يبدو أن النص، مجرد تسجيلٍ لمعرفةٍ ناجزةٍ مسبقًا، كما هو الحال في نمط المنهجية الصارمة. وقد تجسَّد ذلك النمط المنهجي الصارم في عددٍ كبيرٍ نسبيًّا من بحوث الملف، ومن أبرزها “الجمعيات الإسلامية …” (ص 19-39)، و”الإخوان المسلمون …” (ص 45-68)، و”إشكالية التوظيف السياسي …” (ص 263-279)، و”الدين والدولة وسؤال المأسسة …” (ص 349-364)… إلخ. و”ينسى” البحث الأخير “منهجيته الصارمة”، حين يقول (بين قوسين) في إحدى فقراته: “(وربما نأتي على هذه النقطة لاحقًا)”. فمن المفترض أن الباحث قد عرف بعد إنجاز البحث تلك النقطة: أأتى عليها لاحقًا أم لا، وبالتالي كان ممكنًا له حسم الاحتمالات وإعادة صياغة تلك الجملة التي كتبها، عندما لم يكن قد أنجز كتابة البحث.
ليس نادرًا أن تمتزج عناصر النمطين المنهجيين المذكورين، بدرجاتٍ متفاوتةٍ، في النصوص البحثية. وعلى سبيل المثال، نجد هذا الامتزاج واضحًا في بحثي “مدخل إلى دراسة التوريث الديني …”، و”الإسماعيليون في سورية …”. وغالبًا ما تحدد “المجلات الرصينة” بعض المسائل المنهجية التي ينبغي لكتّابها الالتزام بها. ويبدو أن مستوى “الحرية” التي يتمتع بها كتَّاب مجلة قلمون، في هذا الخصوص، عالٍ، وأن درجة “المرونة” التي تتحلى بها المجلة في تعاملها مع نصوص كتَّابها كبيرةٌ إلى درجةٍ تفضي إلى وجود اختلافٍ كبيرٍ بين البنى المنهجية للأبحاث المنشورة في المجلة. ويتضمن ذلك الاختلاف وجود تفاوتٍ بين مستويات الأبحاث، من الناحية المنهجية/ المعرفية، وهو التفاوت الذي قد يبدو أحيانًا أنه أكبر مما يمكن تقبّله أو قبوله، لأنه يفضي إلى وجود بحوثٍ لا تلتزم بالحد الأدنى مما ينبغي للنص البحثي أو الرصين أن يلتزم به. وسأعطي، في ما يلي، بعض الأمثلة عن الاختلاف والتفاوت الكبيرين بين أبحاث الملف في هذا الخصوص.
يمكن للقارئ، على الأرجح، أن يخمن، تخمينًا صحيحًا، الموضوع الذي يتناوله بحث “قانون الأحوال الشخصية السوري وتعديلاته الخجولة في مئة عام”، بمجرد قراءة العنوان. وفي ما عدا ذلك، لا تقدّم الأسطر الخمسة التي يبدأ بها البحث، والتي تسبق العنوان الأول “قانون العائلة العثماني” فيه، أي معلومةٍ تسمح للقارئ بمعرفة موضوع البحث أو إشكاليته أو أطروحته أو أسئلته (الأساسية أو الفرعية) أو منهجيته في تناولها.. إلخ (ص 367)، وتعطي تلك الأسطر الخمسة الانطباع (المخطئ أو المصيب، لا فرق) بأنها والبحث بمجمله مقتطعان من نصٍ أكبر، بطريقةٍ غير مناسبةٍ. ولا يتعلق الأمر هنا، بالدرجة الأولى، بعدد الأسطر التي تتضمنها، أو يُفترض أن مقدمة البحث تتضمنها. فعلى سبيل المثال، مقدمة بحث “العلاقة بين الدين والفن خلال مئة عام من التاريخ السوري”، مؤلفةٌ من عشرة أسطر فقط، لكنها تتضمن توضيحًا معقولًا جدًّا لموضوع البحث وإشكاليته وأطروحته ومضامينه الرئيسة.
ومقابل “الإهمال الكامل” للتحضير المنهجي والمعرفي الذي يمكن وينبغي للبحث أن يتضمنه، في مقدمته أو بداياته، الذي وجدناه في بحث “قانون الأحوال الشخصية …”، نجد أبحاثًا أخرى تغرق، وتُغرق القارئ، في عرض تفصيلاتٍ منهجيةٍ كثيرةٍ، من دون أن تحقق الغرض المفترض من عرض تلك التفصيلات. هذا ما نجده، على سبيل المثال، في بحث “الحركة الصوفية في حلب المعاصرة”. حيث يتضمن القسم الأول من ذلك البحث “تقسيمًا مدرسيًّا” لفقراتٍ ثلاثٍ تحمل العناوين التالية، على التوالي: “إشكالية البحث وأسئلته”، “أهداف البحث”، “منهج البحث” (ص 180-181). ويزداد الانطباع بالسمة المصطنعة لهذا التقسيم، عند قراءة مضامين الفقرات المذكورة. فعلى سبيل المثال، لا يبدو أن فقرة “إشكالية البحث وأسئلته” تتضمن أي إشكاليةٍ. فالإشكالية ليست مجرد سؤالٍ عامٍ، وإنما ينبغي أن يكون هناك إمكانيةٌ، فعليةٌ أو من حيث المبدأ، لتقديم إجاباتٍ مختلفةٍ عنه. وفي تلك الفقرة، لا يبدو أنّ سؤال «ما النشاط الذي تنهض به الحركة الصوفية في الحياة الثقافية لمدينة حلب؟» (ص 180) سؤال إشكاليّ بالفعل، ولا يشير البحث إلى أي إمكانية لوجود أطروحاتٍ أو إجاباتٍ مختلفةٍ عن ذلك السؤال؛ ولا يتضمن التقديم المنهجي أي إشارةٍ إلى وجود أطروحةٍ خاصةٍ يتبناها البحث في خصوص أي إشكاليةٍ. ولا تضيف فقرة “أهداف البحث” جديدًا، في هذا الخصوص، إذ تقتصر، عمومًا، على تكرار ما جاء في الفقرة السابقة بصياغةٍ أخرى. وفي فقرة “منهج البحث”، نجد حديثًا عن “منهج الدراسات الاجتماعية”، وكأنه يوحي بأن لتلك الدراسات منهجًا واحدًا فقط؛ وهذا أمرٌ غير دقيقٍ “بالتأكيد”.
يمكن تكرار القول ذاته، تقريبًا، في خصوص تقسيمات التوضيح المنهجي الذي يتضمنه بحثا “تماثيل الكيتش في سورية” و”صورة الدين الوطني في السينما السوريّة”. فلا تقدم تلك التقسيمات ما يُفترض أنها تسعى إلى تقديمه، بل تتضمن تكرارًا وكلامًا عامًّا، في سياقٍ يستدعي ضبطًا عاليًا للمعنى وللمبنى الذي يعبر عنه. فعلى سبيل المثال، تتضمن فقرة “أهمية البحث” في “صورة الدين الوطني …”، بند “رصد أشكال الثقافة الدينية في بعض الأفلام السوريّة”، ويتكرر البند ذاته تقريبًا في صيغة مختلفةٍ (قليلًا)، عند الحديث عن “أهداف البحث”: “رسم معالم الشكل الديني ضمن الإنتاج الرسمي في سورية …”. وفي فقرة “منهج البحث”، إشارة إلى “الدراسات الثقافية” وإلى “أدوات من النظرية الجمالية السينمائية”، من دون أي توضيحٍ لماهية المنهج الذي تجسده الدراسات الثقافية، وماهية الأدوات المنهجية التي يأخذها البحث من “النظرية الجمالية السينمائية” وماهية هذه النظرية.. إلخ. وباختصارٍ تكثيفيٍّ: يمكن القول إن اللجوء إلى مثل هذه التقسيمات المنهجية كان غير مناسبٍ، ولا موفقٍ، عمومًا، وبدا مصطنعًا أو شكلانيًّا، أي أنه قدم شكلًا لا يتضمن مضمونًا متسقًا معه ومناسبًا له. وثمة غرقٌ وإغراقٌ في تفاصيل مكررةٍ ولا أهمية (كبيرة) لها، وغيابٌ أو تغييبٌ لمسائل أساسيةٍ ومهمةٍ في ذلك الخصوص. وينبغي أن نشير هنا إلى أن البحثين الأخيرين يتضمنان ملخصًا، يساعد، كثيرًا، القارئ في امتلاك فهمٍ أوليٍّ مفيدٍ لمضمون البحث وبنيته وأفكاره الرئيسة.
2) في تقسيم فقرات الأبحاث وعناوينها
نجد في بعض الأبحاث ملخصًا (تنفيذيًّا) و/ أو مقدمةً و/ أو استهلالًا، و/ أو تمهيدًا، وتغيب عناوين كل هذه الفقرات و/ أو مضامينها في أبحاثٍ أخرى. وليس نادرًا أن تزود المجلات الباحثين بالبنية أو البنى المنهجية المطلوبة أو الممكنة أو المرغوبة، بما يساعد هؤلاء الباحثين في ضبط بحوثهم في بنيةٍ منهجيةٍ مناسبةٍ، ويساعد المجلة في تقديم بحوثٍ منضبطةٍ منهجيًّا، تسهل تلقي القراء وفهمهم لها. وربما كان مفيدًا وضروريًّا قيام مجلة قلمون بتحديد التقسيمات التي ينبغي أن يتضمنها البحث، كما تفعل كثير من المجلات. والمشكلة في الاختلافات الكثيرة والكبيرة بين التقسيمات التي تتضمنها أبحاث الملف، والمجلة عمومًا، هو أن تلك الاختلافات، وبعض أشكال/ مضامين تلك الاختلافات، يعرقلان إمكانية فهم القارئ للنصوص.
يتبنى بحث “التصوف وأثره في الجزيرة السورية” تقسيم فقرات البحث، على التوالي، إلى مباحث، ومطالب، ومسائل، وأولًا وثانيًا.. إلخ. لكن تطبيق ذلك التقسيم الخاص وغير الشائع كثيرًا إلا لدى بعض الاختصاصات أو الميادين المعرفية، يبدو غير مناسبٍ ولا مفيدٍ عمومًا. وهذا ما نجده خصوصًا، أو على سبيل المثال، في بحث “التصوف وأثره في الجزيرة السورية”. فبعد المقدمة، يأتي العنوان الأول “المبحث الأول: ماهية التصوف وتاريخ نشأته في الجزيرة”، ثم يليه مباشرةً عنوان فرعيّ أول “المطلب الأول: ماهية التصوف ونشأته”، وعنوان فرعيّ ثانٍ ” المسألة الأولى ماهية التصوف”، وعنوان فرعيّ ثالث “أولًا: معنى التصوف لغةً واصطلاحًا”. وبعد بضعة أسطر تحت بند أولًا، يأتي بند “ثانيًا: سبب تسميتهم بهذا الاسم”. و”الغريب” أن عنوان ذلك البند ليس بالخط العريض، كحال كل العناوين السابقة التي سبقته. ويتكرر الأمر نفسه في العنوان التالي “المسألة الثانية: ماهية التصوف وثمرته ونشأته”، حيث لا يكون الخط عريضًا أيضًا. لكن المثير للاستغراب، ولسوء الفهم أو عدمه، هو أن المسألة الثانية التي يفترض أنها عنوانٌ فرعيٌّ من عناوين المطلب الأول، “ماهية التصوف ونشأته”، تغطي مضمونًا أكبر من المضمون الذي يغطيه المطلب الذي يُفترض أنه يتضمنها. والأمر ذاته يحصل في البند التالي، حيث يكون بخطٍّ عاديٍّ، لكنه يتضمن مساحةً معرفيةً أكبر من تلك التي تتضمنها “المسألة الأولى” التي يفترض أن تغطي مساحة أكبر من المساحة التي يغطيها. وثمة تناقضاتٌ كثيرةٌ، وغموضٌ والتباسٌ كبيران، في هذا الخصوص. وسأكتفي بأن أضع، في ما يلي، العناوين الموجودة في الصفحتين 220-221، لكي أبين بعضًا من تلك التناقضات وذلك الغموض والالتباس. وسأضعها كما هي واردةٌ تمامًا، من حيث ضبط الخط، مثلًا. وسأضعها من دون إضافة أي تعليقٍ عليها أو شرحٍ لها لاحقًا، لأنني أعتقد وأزعم أن تناقضها الذاتي واضحٌ جدًّا.
المبحث الأول: ماهية التصوف وتاريخ نشأته في الجزيرة
المطلب الأول: ماهية التصوف ونشأته
المسألة الأولى ماهية التصوف
أولا: معنى التصوف لغة واصطلاحًا
ثانيًا: سبب تسميتهم بهذا الاسم
المسألة الثانية: ماهية التصوف وثمرته ونشأته
أوًلا: ماهية التصوف وثمرته
ثانيًا: نشأة التصوف
المطلب الثاني: تاريخ التصوف في الجزيرة السورية
المسألة الأولى: نبذة عن الأسر الصوفية في الجزيرة السورية
ويلي ذلك العنوان الأخير، في الصفحة التالية، “عنوانٌ” فرعيٌّ آخر “الأسرة الخزنوية” بالخط العريض، من دون وضوح موقعه التراتبي ضمن تقسيم الفقرات.
ومن الأمور التي يمكن (وينبغي) مناقشتها، والتفكير فيها، مدى معقولية أو ضرورة صياغة نصوص بحوث الملف في “فقرات أو مقاطع paragraphs”، بعيدًا عن الجمل المتقطعة والمنفصلة، في المبنى و/ أو المعنى. الأطروحة الظنية التي نتبناها، جزئيًّا ونسبيًّا، في هذا الخصوص، هي أن الفقرات تمثِّل، أو ينبغي لها أن تمثِّل، الوحدات الأساسية للمعنى في النصوص والخطابات المكتوبة عمومًا. والفقرة هي مجموعة مترابطة ومتكاملة من الجمل، تشكل في مجموعها معنى أو فكرةً مركزيةً أو أساسيةً ما. وفي الخطاب الشفهي المسجَّل أو المدوَّن، أو في النصوص التي تحاكي الخطاب الشفهي أو الأسلوب الخطابي، يمكن فهم الحضور الكثيف للفقرات المكونة من جملةٍ أو جملتين (قصيرتين نسبيًّا). أما في النصوص البحثية/ الفكرية التأملية عمومًا، وفي الفلسفة والعلوم الاجتماعية النظرية خصوصًا، يبدو أن حضور ذلك المعنى في فقراتٍ يكون أكثر منطقيةً ومعقوليةً من حضوره في جملٍ منفصلةٍ عن بعضها بعضًا. ومن البحوث التي يكثر فيها حضور الفقرات المؤلفة من جملة أو جملتين نذكر، على سبيل المثال، بحث “الصوفية في دمشق”، وبحث “الحركة الصوفية في حلب المعاصرة”، وبحث “التصوف وأثره في الجزيرة السورية”. ويبدو، غالبًا، أن الوحدة الأساسية للمعنى، في مثل تلك النصوص، هي الجملة، لا الفقرة، بوصفها مجموعةً أو سلسلةً مترابطة المبنى والمعنى من الجمل المكونة لفكرة واحدة، بمعنى ما. وهكذا نجد أن كل صفحةٍ، تقريبًا، من صفحات تلك البحوث تتضمن غالبًا من سبع إلى عشر فقراتٍ منفصلةٍ، تتألف كلٌّ منها من جملةٍ أو من جملتين، على الأكثر. ونعتقد بأن هيمنة مثل تلك الجمل/ الفقرات قد تكون ناتجةً عن، و/ أو مفضيةً إلى، ضعفٍ، جزئيّ ونسبيّ، على الأقل، للسمة التحليلية والبنائية والحجاجية للنص، وإلى هيمنة السمة الوصفية عليه، بحيث يكون مضمون النص متمحورًا على المعلومات أكثر من كونه متمحورًا حول الأفكار.
3) في المسائل اللغوية والتقنية والتوثيقية
تتضمن المجلة عددًا كبيرًا جدًّا، نسبيًّا، من الأخطاء اللغوية، الطباعية وغير الطباعية، والأخطاء التوثيقية والتقنية والإخراجية.. إلخ. وسأشير، في ما يلي، إلى عددٍ من الأمثلة الدالة على نوعية هذه الأخطاء.
أ) في بعض المسائل اللغوية
من المرجَّح أن معظم الأخطاء اللغوية الواردة في ملفّ المجلة عائدةٌ إلى المصدر المتمثل في النص المرسل من الكاتب؛ حيث إن عدد هذه الأخطاء ونوعها يختلفان من نصٍّ إلى آخر. لكن مسؤولية نشر هذه الأخطاء تقع، في النهاية، على إدارة المجلة، بالدرجة الأولى. وربما كان الحجم الكبير لنصوص ملف العدد الأخير عاملًا مؤثرًا في عدم قدرة القائمين على المجلة على مراجعتها وتدقيقها، من الناحية اللغوية وغير اللغوية. والعدد الأكبر من الأخطاء هو من نوع “الأخطاء الطباعية”. ففي صفحة “المحتويات، التي تضم محتويات العدد المزدوج الأخير (ص 13)، نجد أن اسم “محمد نفيسة” قد أصبح “محمد نفسية“، مع العلم أن الاسم مكتوب برسمٍ صحيحٍ، لاحقًا، في أعلى النص المنشور. وعلى الرغم من عدم وجود أخطاء “كثيرة” في نص “كلمة العدد”، فإننا نجد كلمة “دميعهم” بدل كلمة جميعهم، وتكرارًا خاطئًا لحرف الجر “من” (ص 13). ومن الواضح انتماء مثل هذه الأخطاء إلى “النوع الطباعي”، خصوصًا أن حرفي “الجيم والدال، متجاوران في لوحة المفاتيح، وكذلك حال حرفي السين والياء. ومن الأخطاء الكثيرة التي تنتمي، غالبًا، إلى هذا النوع الطباعي، أخطاءٌ متعلقةٌ بغياب همزة القطع، كما الحال في كلمتي “الإخوان” (ص 232) و”الإرشاد” (ص 234)، على سبيل المثال؛ لكن ربما كانت بعض الأخطاء المتعلقة بالهمزات ليست من النوع الطباعي، ككتابة الهمزة خطأً على ألف مقصورة، “تفاجئ”، بدلًا من كتابتها على ألف ممدودة، “تفاجأ”: (غير أنه تفاجئ بعد ذلك بلجوئه إلى الخيار العسكري، ص 78).
ومن الأمثلة على الأخطاء الطباعية، أيضًا، كتابة “ا” بدلًا من “لا”، و”السياسية”، بدلًا من “السياسة”، و”مكونات” بدلًا من “المكونات”، و”مجتع” بدلًا من “مجتمع”، و”يجعنا” بدلًا من “يجعلنا”، و”تراحع” بدلًا من “تراجع”، و”بسم” بدلًا من “باسم”، و”عى” بدلًا من “على”، و”بسب” بدلًا من “بسبب”، و”الأقليلت” بدلًا من “الأقليات”، و”هنك” بدلًا من “هناك”، و”بوصهم” بدلًا من “بوصفهم”، و”المذهية” بدلًا من “المذهبية”، (ص 151، 316، 323، 324، 325، 328)، واستخدام الألف الفارقة مع “واو الجمع”، في كلمة “مؤسسو”، أي كتابتها “مؤسسوا” (ص 227)، وإضافة ألف التثنية إلى فعل “شاع” بدون مسوغٍ” (ص 128). ومن الأخطاء الطباعية/ التقنية، كتابة تاريخ 1190-1350 الوارد في عنوان أحد الكتب المستخدمة في بحث “التوريث الديني”، بالشكل التالي “11901350”. (ص 259)، وفي الصفحة ذاتها، وفي صفحاتٍ أخرى (ص 202، 236، على سبيل المثال) هناك أخطاء متعلقة بعلامات الترقيم: عدم وجود فاصلة، بعد ذكر دار النشر، وعدم وجود “نقطة” في نهاية توثيق المرجع. ووجود مثل هذه الأخطاء، في صفحات الملف، ليس نادرًا، على الإطلاق.
ومن المرجَّح ألا يكون تعبير “سدق اللسان” الوارد في بحث “الموحدون الدروز …” (319)، للدلالة على “صدق اللسان”، خطأً طباعيًّا أو خطأً لغويًّا، من منظورٍ درزيٍّ عقائديٍّ أو أيديولوجيٍّ([8]). لكن يبقى السؤال عن مدى معقولية قبول ذلك الرسم للكلمة في نصوص المجلة، أو في النصوص غير الدينية، خصوصًا عندما لا تكون الكلمة أو الجملة الواردة ضمنها موضوعةً ضمن علامتي تنصيص/ اقتباس “”/ « ». والسؤال ذاته تقريبًا يمكن طرحه في خصوص رسم الكلمة الدالة على الناس المنتمين إلى الاثنية الكردية. ففي الملف، وخارجه، هناك، على الأقل، ثلاثة رسومٍ مختلفةٍ، بل متصارعة أحيانًا أيضًا: كرد (ص 11، 137، 223، 251، 309، 316)، أكراد (ص 74، 81، 167، 225، 233، 340) الكوردي (ص 233-236). فثمة بعدٌ أيديولوجيٌّ متنامي القوة في رسم هذه الكلمة، وربما كان ممكنًا ومفيدًا ضبط ذلك الرسم والصراع معرفيًّا، أو اتخاذ موقفٍ معرفيٍّ منه.
والأخطاء اللغوية الموجودة في المجلة هي من النوع النحوي، أحيانًا، بدون أن ينفي ذلك إمكانية أن تكون من النوع الطباعي، في الوقت نفسه. ومن الأخطاء النحوية، على سبيل المثال، رفع المثنى بالياء، بدلًا من رفعه بالألف (ولكنهما مطعمتين، ص 322)، ونصب الاسمين المرفوعين بعد ثمة (ثمة تحالفًا مسكوتًا 326)، ورفع خبر كان المنصوب (أن يكونوا مواطنون، ص 333). وهناك استخدام خاطئ لفعل “رافقت”، حيث كان ينبغي حينها أن يستخدم مع ألف التثنية “رافقا”. (ص 327) ومن تلك الأخطاء، أيضًا، حذف نون الفعل المضارع المنتمي إلى “الأفعال الخمسة”، عندما لا يكون منصوبًا أو مجزومًا (ولكنهم يسكتوا 332)، وعدم تصريف مصطلح “الموحدون الدروز” أحيانًا، وتصريفه تصريفًا صحيحًا أو خاطئًا، في أحيانٍ أخرى. (“عقيدة الموحدين الدروز”، ص 315، “إنّ استقرار الموحدون الدروز”، ص 320، “من الموحدون الدروز”، ص 321).
ومن المسائل اللغوية/ النحوية المثيرة للانتباه، مسألة موضع تنوين النصب/ الفتح في الكلمات المنتهية بألف ممدودةٍ/ ألف الإطلاق. فمن “المعروف” أن هناك اتجاهين أو توجُّهين رئيسين في هذا الخصوص: اتجاه يرى وضعها على الألف، واتجاه يرى وضعها على الحرف الذي يسبق الألف. وتطبِّق المجلة الاتجاه الأخير، وهو الاتجاه الأدق من وجهة نظري (المتواضعة)، ويحظى بانتشارٍ متزايدٍ عمومًا. المسألة الإشكالية الواجب الانتباه إليها، في هذا الخصوص، تكمن في أن الحرف الذي يسبق الألف قد يكون مشددًا؛ وفي هذه الحالة ينبغي أن يوضع التنوين على الشدة لا على الحرف المشدَّد مباشرةً. في نصوص المجلة، يوضع التنوين المذكور على الحرف المشدّد، وتُهمل الشدّة تمامًا، في هذا السياق! ووجهة نظر المجلة في هذا الخصوص غير واضحة.
وفي نهاية كل بحثٍ، هناك قائمةٌ بأسماء المصادر والمراجع التي استند إليها البحث. وبغض النظر عن الاختلاف في العناوين المستخدمة لهذا الغرض (“بلغات أجنبية”، “بلغة أجنبيةٍ”، “اللغة الأجنبية”، “الأجنبية” … إلخ)، بين الأبحاث، وهو الاختلاف الذي قد يكون من الأفضل تجنبه، وإيجاد نموذجٍ موحدٍ لهذا الغرض، فهناك عنوانٌ بحاجةٍ إلى تصحيحٍ: “بلغة الأجنبية” (ص 153).
وهناك أخطاءٌ شائعةٌ تتعلق بحروف الجر، وحاضرةٌ، بدرجاتٍ متفاوتةٍ، في صفحات “الملف”. ففي صفحة “المحتويات”، وفي عنوان كلٍّ من بحث “التصوف وأثره في الجزيرة السورية”، وبحث “حضور الصورة في المجتمع السوري الحديث وأثر الرقيب الديني عليها”، هناك حرفا جر مختلفان مستخدمان مع كلمة “أثر”: “على” و”في”؛ والصواب استخدام “في”، لا “على”. وكذلك هو الحال مع حرف الجرّ المستخدم مع فعل “الاستناد”، إذ إن الصواب استخدامه مع “إلى”، لا مع “على” (ص 65).
ومن الأخطاء الشائعة الواردة أحيانًا، في “الملف” أيضًا، الاستخدام الخاطئ، أحيانًا، لألفاظ العقود، حيث تُستخدم، على سبيل المثال، كلمتا “السبعينات” و”الثمانينات”، بدلًا من كلمتي “السبعينيات” و”الثمانينيات” (ص 264)، كما يُستخدم فعل “نوَّه” استعمالًا خاطئًا في سياق يراد منه الإشارة فقط إلى أمرٍ ما، وليس التنويه أو الإشادة به (ص 292)، وهناك أيضًا تعديةٌ للفعل “يسمح” إلى المفعول به، بحرف الجر “في” (يسمح في بناء المؤسسة، ص 353)، مع أن الصواب، في ذلك السياق، تعديته بحرف الجر “ﺑ”.
على الرغم من أن الأخطاء اللغوية المشابهة للأخطاء اللغوية المذكورة تمثل الكم الأكبر من الأخطاء الموجودة في نصوص “الملف، فنحن نعتقد أنها أقل الأخطاء “سوءًا”، مقارنةً بالأخطاء، اللغوية وغير اللغوية، الأخرى؛ لأن أقصى تأثيراتها السلبية تكمن، على الأرجح، في إثارة نفور القارئ أو الإسهام في نشر استخدامٍ خاطئٍ للغة العربية، ولأنها، عمومًا، لا تؤثر تأثيرًا سلبيًّا (كبيرًا) في معنى النص وفهمه من قِبَل القارئ، كما تفعل عددٌ من الأخطاء الأخرى. في بحث “القُبَيْسيّات”، نجد الكلام التالي موضوعًا بهذا الترتيب:
«2. مؤيدو القبيسيات
تمثل هذا الاتجاه في بعض الشخصيات التي تتصل اتصالًا مباشرًا ﺑ”القبيسيات” وتعد من مرجعياته الروحية كأحمد كفتارو حيث كان يقدر الآنسة منيرة كثيرًا ويخاطبها بالبطلة، أما ساعده الأيمن محمد بشير الباني ووريثه فيصفها بالشمس.
والفكرية كالدكتور البوطي الذي أشاد بسلامة منهجهن وبحسن ولائهن للوطن، …» (ص 107).
كما هو واضحٌ، فإن هناك جملةً واحدةً مقسَّمةً، بطريقةٍ غير صحيحةٍ، ليس إلى جملتين منفصلتين انفصالًا مخلًّا بالمبنى والمعنى، فحسب، بل إلى فقرتين أيضًا. ولا نعرف مصدر الخطأ: أهو من كاتب البحث، أم من التحرير و/ أو الإخراج، لكن من المؤكد عدم مقبولية وجود مثل هذه الأخطاء عمومًا، لكونها تعرقل الفهم، أو تؤخر حصوله، في أحسن الأحوال.
وفي بحث “التصوف وأثره في الجزيرة السورية”، نقرأ الجملة التالية: «ولا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين النظام السوري والطرق الصوفية ليست وليدة مرحلة الثورات الراهنة، ولا تلك التي سبقتها بقليل، فالعلاقة بينها تعود إلى بدايات نشأة الدولة السورية بل يعيدها بعضهم إلى بدايات نشأة التصوف في سورية عمومًا». (ص 232) وبغض النظر عن الخطأ اللغوي المتمثل في استخدام “بينها”، يبدو أن جزءًا، على الأقل، من هذه الجملة غامضٌ و/ أو غير مفهومٍ، أو أنه غير قابلٍ للفهم “أصلًا”، بسبب تناقضه الذاتي. فالجملة تتضمن القول بأن العلاقة بين النظام السوري والطرق الصوفية ليست جديدةً، حيث إنها “ليست وليدة مرحلة الثورات الراهنة، ولا تلك التي سبقتها بقليل”. ما يبدو أنه غير قابلٍ للفهم فعلًا هو الحديث عن أن العلاقة بين النظام السوري والطرق الصوفية تعود إلى ما قبل بدايات نشأة الدولة السورية. فليس واضحًا ماهية النظام السوري الذي كان موجودًا قبل بدايات نشأة الدولة السورية، أو كيف أمكن وجود نظامٍ سوريٍّ أصلًا، قبل نشوء “الدولة السورية”!
وتتضمن خاتمة/ نتائج بحث “صورة الدين الوطني في السينما السوريّة” كلامًا مضطرب المبنى وغامضًا أو غير صحيح المعنى، في الوقت نفسه. فهناك جملٌ بالغة العمومية تفتقر إلى وجود محددات الجهة والزمان والمكان.. إلخ. ومن دون تلك المحددات، يصعب فهم المعنى و/ أو الموافقة عليه في حال فهمه تخمينًا. هذه هي الحال، على سبيل المثال، في النتيجة/ الجملة الأولى من نص الخاتمة التي تبدأ مباشرةً بما يلي: «1. الدين عابر للتاريخ، ولا يتعرض للنقد، بل يُعدَّل وفق الشرط الأيديولوجي والمتغيرات السياسيّة، مع ذلك هو أبديّ، ويحمل الصراعات الوطنيّة الأبديّة المرتبطة بالعدو ومواجهته» (ص 471)، فمن المؤكد أن البحث لم يتضمن ما يسمح له بالوصول إلى هذه النتيجة العامة جدًّا التي تتضمنها جملة “الدين عابر للتاريخ” أو “الدين أبديٌّ”. وإذا كانت العمومية الشديدة للجملة الأولى ليست إشكاليةً جدًّا، لأنه من المرجح ألا يختلف كثيرون حول مضمونها؛ فإن السمة الإشكالية للجملة التالية -“لا يتعرض للنقد”- أكبر، ويمكن ويرجح أن تكون قادرةً على إنتاج سوء أو عدم فهمٍ، ومعارضةً شديدةً لمعناها. ولهذا ينبغي ضبط مبنى الجملة، وتزويده بالكلمات المحددة للجهة والزمان والمكان.. إلخ. وقد تكون الجملة التالية مناسبةً أكثر للمعنى الذي يمكن تخمين أن “الجملة الأصلية المذكورة” تسعى إلى التعبير عنه: “لا يتعرض الدين للنقد، غالبًا على الأقل، في النتاج السينمائي السوري، في العقود الخمسة الأخيرة، على الأقل”.
وفي النتيجة الرابعة المعروضة من نتائج البحث المذكور، هناك اضطرابٌ في المبنى، وثلاثة أخطاءٍ لغويةٍ، على الأقل: “سياسًا” بدلًا من “سياسيًّا”، وتفتقر الجملة إلى حرف الجر “على” لفعل يحافظ، وإلى حرف عطفٍ قبل فعل “يتبنى”. ويمكن لهذه الأخطاء أن تثير الشكوك في المعنى والمبنى، معًا: «4. يقدم النظام السوري نسخة من الدين التقدمي والنظيف الذي لا يشكل تهديدًا سياسًا له، في الوقت ذاته يحافظ يتبنى المقولات الدينيّة الإصلاحية، ويدخلها في الثقافة الوطنيّة» (ص 472). وتبدو الجملة الأخيرة مضطربة الصياغة بسبب الأخطاء اللغوية، من جهةٍ، وبسبب افتقارها إلى أي علامة ترقيمٍ، باستثناء وجود النقطة في نهايتها: «6. يتحول الدين إلى أداة دعائية يوظفها النظام السوري لمحاربة أعدائه وإعلاء قيمته على حساب انحطاط الأعداء سواء كانوا أجانب أم سوريين الذين تنفى عنهم الوطنيّة في حال خالفوا الشكل الديني الرسمي» (ص 472).
ب) في خصوص علامات الترقيم
الإشارة السابقة إلى مسألة علامات الترقيم لم تكن الوحيدة، في دراستنا الحالية. وثمة مواضع كثيرةٌ يبدو فيها استخدام تلك العلامات إشكاليًّا. ومن ضمن الأخطاء الطباعية التي أشرنا إليها آنفًا، ثمة عددٌ كبيرٌ من الأخطاء المتعلقة بعلامات الترقيم. فعلى سبيل المثال، في الجملة الأولى من “كلمة العدد”، يبدو أن النية كانت معقودةً على وضع جزءٍ من تلك الجملة بين شرطتين “- -“، لكن حصل خطأٌ ما جعله يقتصر على الشرطة الأولى، ويسهو عن وضع الشرطة الثانية: «قد يكون من المفيد التذكير بأن مجلة قلمون -التي صدر عددها الأول عام 2017 في ذكرى الفيلسوف والمفكر السوري (صادق العظم) ولدت بوصفها مشروعًا ثقافيًا يملكه السوريون جميعهم» (ص 9). وكحال الأخطاء الطباعية عمومًا، معظم تلك الأخطاء غير معرقلةٍ للفهم.
أشرنا سابقًا إلى إشكالية تحويل الفقرة إلى مجرد جملة قصيرةٍ أو جملتين قصيرتين، في بعض النصوص. وما نود مناقشته، في السياق الحالي، هو مشكلةٌ/ إشكاليةٌ نواجهها، في نصوصٍ أخرى، وتتمثل في تحويل الجملة إلى فقرة كاملة الأركان، تتضمن عددًا كبيرًا من الجمل الفرعية. وهذا ما نجده، خصوصًا أو تحديدًا، في بحث “التوريث الديني”، حيث تتكوَّن معظم الفقرات -المؤلفة غالبًا من عشرة أسطرٍ على الأقل- من جملةٍ طويلةٍ واحدةٍ، أو من جملتين طويلتين، فقط. وهكذا، ليس نادرًا أن يفوق حجم الجملة، في ذلك النص، عشرة أسطرٍ، وأن يصل، أحيانًا، إلى أكثر من خمسة عشر سطرًا. وقد يكون ممكنًا المحاجّة بوجود أفضليةٍ ومعقوليةٍ كبيرتين، في تجنب تحويل الفقرة إلى جملةٍ قصيرةٍ أو جملتين قصيرتين، من جهةٍ، وتحويل الجملة إلى فقرةٍ كبيرةٍ مؤلفة من عددٍ كبيرٍ (“جدًّا”) من الأسطر، من جهةٍ أخرى. ويتطلب ذلك استخدامًا واعيًا لوظائف علامات الترقيم عمومًا: للفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطة وعلامات التنصيص/ الاقتباس والأنواع المتعددة من الأقواس وأدوات الفصل والوصل… إلخ. وعلى الرغم من أن مسألة استخدام علامات الترقيم ذوقيةٌ، جزئيًّا ونسبيًّا، وغير خاضعةٍ لقواعد صارمةٍ ومفصَّلةٍ، فقد يكون بالإمكان المحاجّة في شأن ماهية الوظيفة التي يؤديها حضور أو غياب هذه العلامة من علامات الترقيم أو تلك. وقد يكون ضروريًّا أو مفيدًا، على الأقل، لفت الانتباه إلى مثل هذه المسألة وإخضاعها للتفكُّر الذاتي، والتفكير المشترك من خلال النقاش مع الآخرين؛ لأنه يبدو أنها ما زالت هشة الحضور والأسس، ومستجدةً، جزئيًّا ونسبيًّا، في ثقافتنا المكتوبة.
ومن أهم علامات الترقيم التي نرى إشكاليةً في استخدامها، في المجلة عمومًا، نذكر علامات التنصيص والأقواس بأنواعها المتعددة. ومن الشائع استخدام أحد الأشكال التالية: « »، “”، (( )) كعلامات تنصيصٍ في النصوص المكتوبة باللغة العربية. ونجد في نصوص الملف خلطًا أو عدم تمييزٍ واضحٍ بين علامات التنصيص، الأولى والثانية، من جهةٍ، والقوسين الهلاليين”()”، من جهةٍ أخرى. وعلى الرغم من أن هذه العلامات مستجدةٌ في ثقافتنا المكتوبة/ الكتابية، كما أشرنا آنفًا، فثمة اتفاقٌ على وجود اختلافٍ نسبيٍّ، في الوظيفة والمعنى، بين علامات التنصيص/ الاقتباس، من جهةٍ، والقوسين الهلاليين، من جهةٍ أخرى. فعلى سبيل المثال، إذا أردنا أن نبدي تحفظنا على أحد أو بعض أو كل المعاني الممكنة لكلمةٍ أو لفظةٍ ما، أو أن نعلِّق الحكم في خصوص هذا المعنى أو تلك المعاني، فإننا نستخدم علامتي التنصيص، لا القوسين الهلاليين. وتتضمن “كلمة العدد” استخدامًا كثيفًا نسبيًّا للقوسين الهلاليين، في مواضع نرى أنه كان ينبغي فيها استعمال علامتي تنصيصٍ، أو عدم استعمال أقواسٍ مطلقًا. فعلى سبيل المثال، ليس واضحًا معنى أو وظيفة الأقواس المستخدمة في تلك الجملة الواردة في كلمة العدد: «وفي ضوء ذلك لا يكون جوهر (الثقافة) قائمًا في مجرد (المعرفة)، ولا في (المعرفة المجردة) أيضًا» (ص 9)، ولا يبدو واضحًا أي الوظائف المعروفة للقوسين الهلاليين مقصودةٌ، في هذا السياق، لكن لا يبدو لنا أنها تقوم أو يمكن أن تقوم بأيٍّ منها هنا. والمرجح أنها مستخدمةٌ، هنا، لتقوم بوظيفةٍ أو أكثر من الوظائف التي ينبغي أن تقوم بها عادةً إحدى علامتي التنصيص “” أو «»، للحديث عن الألفاظ الموضوعة بين قوسين -“الثقافة” و”المعرفة” و”المعرفة المجردة”- واجتذاب الانتباه إليها، وإبراز (أحد) معانيها، والتحفظ على أحد هذه المعاني أو الاستخدامات وإبراز معنًى آخر.. إلخ. ولأسبابٍ تقنيةٍ وعمليةٍ، نقترح استخدام علامتي التنصيص التاليتين «» كعلامتي اقتباس، والعلامتين التاليتين “” للوظائف الأخرى لعلامات التنصيص. والوظائف المتمايزة لعلامات الاقتباس والأنواع المختلفة للأقواس، في نصوص المجلة، ليست واضحة. ونعتقد بضرورة الانتباه إلى هذه المسألة، لأن تلك العلامات لا تتعلق بمسائل شكليةٍ فحسب، بل إنها تؤدي وظائف مهمةً تتعلق بالمضمون والمعنى، بالدرجة الأولى.
وفي خصوص التدقيق اللغوي وغير اللغوي للنصوص التي تنشرها المجلة، نعتقد بضرورة إرسال التعديلات والتنقيحات التي ترى المجلة ضرورة إدخالها أو إجرائها في النص إلى كاتب النص، قبل اعتمادها، خصوصًا حين يكون الأمر متعلقًا، لا بأخطاء لغويةٍ واضحةٍ ولا خلاف عليها عمومًا، وإنما بمسائل إشكاليةٍ مختلفٍ عليها. وفي كل الأحوال، نرى أنه ينبغي عدم نشر النص قبل موافقة كاتبه، وصاحب التوقيع الوحيد المعلن عليه، على كل مضامين النسخة الأخيرة منه. وهذا هو الإجراء المعتمد عادةً في المجلات الأكاديمية والبحثية الرصينة.
ج) في خصوص بعض المسائل التوثيقية والتقنية
يُعدّ التوثيق (الصحيح) من أهمّ مقوِّمات النصوص البحثية. وكما هي الحال في المجلات الأكاديمية والرصينة، هناك طريقة موحدة للتوثيق تعتمدها مجلة قلمون، ومركز حرمون الذي يصدرها عمومًا، وهي معلنةٌ على صفحة المجلة الإلكترونية ([9]). وعلى الرغم من التزام بحوث المجلة بتلك الطريقة الموحدة عمومًا، فثمة ملاحظاتٌ كثيرةٌ ينبغي الإشارة إليها، والتنبيه عليها، و/ أو التنبُّه إليها.
تتضمن المجلة عددًا (كبيرًا) من المشكلات في التوثيق، عمومًا، وفي توثيق المنشورات الإلكترونية، خصوصًا. وبعض هذه المشكلات ناتجٌ عن الطريقة التي يتبعها المركز في هذا الخصوص، لكن هناك مشكلات أخرى ناتجة عن عدم تطبيق تلك الطريقة (تطبيقًا صحيحًا). فهناك عددٌ كبيرٌ من الروابط الإلكترونية التي لا تعمل، أو التي تكون روابط صفحاتٍ أخرى غير الصفحة التي يُفترض أن البحث يوثقها. ولا يوجد في طريقة التوثيق التي تعتمدها المجلة إشارة إلى ضرورة أن يتضمن التوثيق تحديد التاريخ الأخير لزيارة الموقع الإلكتروني وتوثيقه، على الرغم من أن هذا الأمر أساسيٌّ ومهمٌّ ومعتمدٌ غالبًا، لأن المنشورات والصفحات الإلكترونية قد تخضع للتعديل والتغيير والتطوير والحذف.. إلخ. وإذا كانت بعض الروابط تحيلنا على صفحةٍ إلكترونيةٍ لا تعمل، حيث تظهر، على سبيل المثال، إشارة 404 (مثلًا، التوثيق رقم 70، ص 128، والتوثيق رقم 37، ص 301، والتوثيق 68، ص 308، والتوثيق 86، ص 312)، فهناك روابط تحيلنا على الصفحة الإلكترونية الرئيسة للموقع الذي نشر النص الذي يريد البحث توثيقه، بدلًا من وضع رابط الصفحة التي نشر فيها هذا النص تحديدًا (مثلًا، التوثيقات 62، ص 307، والتوثيق 70، ص 309، والتوثيق 85 ص 312)، وهناك روابط تحيلنا على صفحاتٍ مختلفةٍ عن تلك التي يُفترض أن الرابط يوثقها (مثلًا، التوثيق 84، ص 312). وفي توثيق مقالٍ منشورٍ إلكترونيًّا، يكتفي البحث بذكر اسم الكاتب، ولا يذكر لا عنوان المقال ولا تاريخ نشره (التوثيق 32، ص 298).
وثمة معلوماتٌ خاطئةٌ أو ناقصةٌ أو غير مطلوبةٍ، في توثيق يعض المراجع غير الإلكترونية، أيضًا. فالتوثيق رقم 100 (ص 210) يتضمن أن “موسوعة المواويل الحلبية” صادرةٌ عن “دار القلم” في حلب، في حين أن الموسوعة صادرةٌ عن “دار القلم العربي”، فضلًا عن أن مقر “دار القلم” في دمشق، وليس في حلب. وفي بعض الأحيان، لا وجود، في التوثيق، لمكان نشر المرجع، أو تاريخ نشره، ولا ذكر لسبب عدم وجود ذلك (مثلًا، التوثيق 24، ص 218، والتوثيق 36، ص 249)، وثمة تغييب مقصود، على الأرجح، وهو غير مفهوم المسوغات، لاسمَي مترجمَي أحد المراجع (التوثيق 38، ص 324). ونحن نقول إن ذلك التغييب مقصودٌ، لأنَّ اسمَي المترجمين موجودان في توثيق المرجع، في قائمة المصادر والمراجع (التوثيق 10، ص 333). وفي توثيق أحد المراجع في قائمة المصادر والمراجع، يُشار إلى أن الكتاب إلكترونيٌّ، وإلى عدم وجود مكان نشر أو ناشر أو تاريخ نشر، لكن توثيق الكتاب في حواشي البحث، يتضمن إحالةً على “مدونة أبو عبدو البغل”([10]) (ص 324)، وهي مدونةٌ يقوم القائمون عليها بتصوير بعض الكتب وتوفير روابط لتحميلها؛ ولا علاقة لها بنشر الكتاب، ولا معنى لذكرها في توثيقه.
وثمة زياداتٌ غير ضروريةٍ في التوثيق، أحيانًا. ومن تلك الزيادات، ذكر أن التاريخ ميلاديٌّ في بعض التوثيقات، وعدم ذكر ذلك في توثيقاتٍ أخرى موجودةٍ في الصفحة ذاتها (ص 218). وعادةً لا حاجة لذكر أن التاريخ ميلاديٌّ. والأمر ذاته يمكن قوله عن وضع كلمة “عام” أو “سنة”، قبل ذكر تاريخ النشر في بعض التوثيقات. فلا حاجة أو ضرورة لذلك، وليس معتادًا أو مطلوبًا حصوله (ص 242، 248، 258). وهناك زياداتٌ خاطئةٌ ناتجةٌ عن أخطاءٍ تقنيةٍ ما. ففي حواشي الصفحتين (ص 237، 238)، نجد أرقامًا مزدوجةً للتوثيق، أحدها صحيحٌ والآخر خاطئٌ. ومن الأخطاء التقنية الإخراجية المربكة، التفاوت الكبير في مساحة هامش الفقرات والصفحات، من دون أيّ معنى أو داعٍ. وهذا ما نجده، خصوصًا أو تحديدًا، في الصفحات (ص 92-98). ومن المسائل التقنية التوثيقية التي ينبغي الانتباه إليها، أيضًا، مسألةٌ تتعلق بوضع روابط المنشورات الإلكترونية التي يتم توثيقها. فوفقًا لطريقة التوثيق التي تعتمدها المجلة، ينبغي وضع الرابط مختصرًا في نهاية كل توثيقٍ. ووفقًا لملاحظتي، كل الروابط الإلكترونية الموضوعة، أو معظمها على الأقل، ليست مختصرةً، وهي موضوعةٌ بطريقةٍ لا تسرّ العين كثيرًا (انظر، على سبيل المثال: ص 31، 33، 69، 142، 143، 144، 244، 250). وربما كان الحصول على الرابط المختصر أمرًا ليس سهلًا، ولهذا السبب، ولأسبابٍ أخرى، توفر بعض المواقع الإلكترونية -ومنها بعض المواقع التي تم توثيق بعض صفحاتها في الملف- “الرابط الإلكتروني المختصر” لكل صفحةٍ من صفحاتها. ومع ذلك، لم يتم الاستعانة بذلك الرابط المختصر، لتوثيق الصفحة المعنية المستند إليها، في بعض أبحاث الملف (ص 145).
8- خاتمة: نظرة إجمالية
سعت هذه الدراسة إلى تناول مجلة قلمون عمومًا، وملف عددها المزدوج الأخير خصوصًا، من منظور العلاقة بين طرفي ثنائية الثقافة والسياسة، وما يتقاطع أو يتشابه معها من ثنائياتٍ أخرى، مثل ثنائية المعرفة والأيديولوجيا، وثنائية الموضوعية والذاتية، بالدرجة الأولى. وعلى الرغم من محدودية هذا المنظور، بوصفه منظورًا، فقد سعت هذه الدراسة إلى إبراز معقوليته، وضرورة أخذه، وأخذ نتائجه، في الحسبان. وربما أفضى هذا المنظور أو (آلية) تطبيقنا له، في هذه الدراسة، إلى تقديم نظرةٍ وانطباعاتٍ معياريةٍ غير متوازنةٍ عن المجلة، بسبب ما يبدو أنه زيادة التركيز على السلبيات، وعدم التركيز، بالقدر نفسه، على الإيجابيات. ولذلك نودّ تصحيح تلك النظرة والانطباعات المفترضة، والتشديد على أن المجلة تضم عددًا من الأبحاث المهمة، والرائدة في مجالها، وأن تلك البحوث لا تستحق القراءة، تستحق أن تكون موضع نقاشٍ، وأساسًا لبناءٍ وتراكمٍ معرفيين، أيضًا.
لعل النقطة الأبرز التي تتكثف فيها إيجابيات المجلة وسلبياتها، والنتيجة الأبرز التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة، هي أن المجلة طموحةٌ، بل مفرطةٌ في طموحها، وأنها بحاجةٍ إلى إيجاد توازنٍ ما بين طموحاتها وإمكاناتها. ويمكن الاستناد إلى هذه الدراسة للقول بأن هذا التوازن غائبٌ، جزئيًّا ونسبيًّا، عمومًا، وفي العدد المزدوج الأخير، على الأقل، خصوصًا، وبأن حاجة المجلة إليه ماسةٌ.
إن سعي المجلة إلى إقامة جدلٍ إيجابيٍّ بين الثقافة والسياسة أفضى بها أحيانًا إلى تقديم “تنازلاتٍ معرفيةٍ” كبيرةٍ، لأسبابٍ متعددةٍ، من بينها السعي إلى استقطاب فاعلين أو ممثلين سياسيين للأطراف والاتجاهات السورية الأيديولوجية والسياسية وغير السياسية المختلفة. وعلى الرغم من تصلب أو أحادية الموقف الأيديولوجي الذي أعلنت أو أعادت المجلة تبنيه في “كلمة العدد الأخير”، وفي الأعداد السابقة عمومًا، فإنها أبدت أحيانًا مرونةً معرفيةً كبيرةً في قبول آراءٍ تتناقض تمامًا لا مع موقفها الأيديولوجي المعلن فحسب، بل مع الحدود الدنيا من معايير النشر التي أعلنتها، أو مع أي معايير نشرٍ “معقولةٍ” أيضًا. وقد سعت هذه الدراسة إلى إبراز فداحة الثمن المدفوع في بعض الأحيان، وإلى ضرورة (إعادة) التفكير في مدى معقولية أو مقبولية الاستمرار في دفع ذلك الثمن، والنتائج والجدوى المعرفية والأيديولوجية المتحققة منه.
وإضافةً إلى الإفراط الكيفي في الطموح، ثمة إفراطٌ كميٌّ أيضًا. فالعدد المزدوج الأخير يتضمن سبعةً وثلاثين نصًا، من بينها ثلاثةٌ وعشرون نصًّا ضمن ملف العدد. وهذا عددٌ ضخمٌ جدًّا، وبحاجةٍ إلى فريق عملٍ كبيرٍ، ولست متأكدًا من أن المجلة، بإمكاناتها البشرية الحالية، قادرةٌ على أن تضمن تحقيق كل هذه النصوص الحدود الدنيا المطلوبة، و/ أو المفترض وجودها، في النصوص البحثية الرصينة. وبناءً على مراجعتنا لبعض مضامين أبحاث الملف، ولبعض المسائل اللغوية والتقنية والتوثيقية المرتبطة به، نرى أن من الإنصاف القول إنه على الرغم من القيمة المعرفية الكبيرة لملف العدد المزدوج، ولعددٍ كبيرٍ من البحوث المنشورة فيه، فإن كمًّا كبيرًا من المضامين المعرفية لبعض أبحاثه كان بحاجةٍ إلى وقفةٍ صارمةٍ، من القائمين على المجلة ومحكميها ومحرريها، لأنها تضمنت، من وجهة نظرنا، ما لا ينبغي قبوله أو السماح به، من الناحية المعرفية على الأقل. يُضاف إلى ذلك أن كمية الأخطاء اللغوية والتوثيقية والتقنية في المجلة أكبر بكثيرٍ مما هو معتادٌ ومقبولٌ، وعددها كبيرٌ إلى درجةٍ تستدعي، من وجهة نظرنا، إعادة تحرير العدد المزدوج الأخير، وتدقيقه، وإصدار نسخةٍ جديدةٍ منقحةٍ منه. ونحن نرى ضرورة ذلك، ليس بسبب الكم الهائل من الأخطاء الموجودة فيه فقط، بل أيضًا بسبب القيمة المعرفية الكبيرة لعددٍ كبيرٍ من بحوثه التي نرى أنها ستظل مستقبلًا مرجعًا أساسيًّا أو مهمًّا للباحثين والمختصين، في هذا المجال.
يمكن النظر إلى النقد الذي وجهته هذه الدراسة إلى المجلة، وملف عددها الأخير، على أنه نقدٌ ذاتيٌّ بأكثر من معنى. فمن ناحيةٍ أولى، هو نقدٌ ذاتيٌّ، لأنَّ مجلة قلمون هي مجلتنا جميعًا، نحن السوريين، كما تؤكد محقةً افتتاحية العدد. ولا شك في أن المواضيع التي طرحتها مجلة قلمون، في أعدادها الأربعة عشر الصادرة حتى الآن، والمضامين التي تناولت من خلالها تلك المواضيع، جعلت سوريين كثرًا يشعرون بالانتماء إلى هذه المجلة، وبأنها مجلتهم، بمعنًى ما. ومن ناحيةٍ ثانيةٍ، هذا النقد هو نقدٌ ذاتيٌّ (أيضًا)، لأن كاتب هذه الدراسة النقدية هو أحد كتَّاب المجلة، منذ عددها الأول، وإلى حين كتابة هذا النص، على الأقل. وبالتالي، ثمة ما يسوغ شعوره أو اعتقاده بأن المجلة “مجلته”، وبأنه جزءٌ من أسرة المجلة. ومن ناحيةٍ ثالثةٍ وأخيرةٍ، النقد الذي تضمنته هذه الدراسة هو نقدٌ ذاتيٌّ، لأنه ليس نادرًا أن تتضمن نصوص كاتبه بعضًا من السلبيات التي انتقدها، وربما غيرها أيضًا.
وفقًا لعنوان هذه الدراسة، فإنها دراسةٌ نقديةٌ لملف مجلة قلمون “التفاعل بين الدين والمجتمع في سورية 1920-2020”. لكن الدراسة كانت عاجزةً -بالتأكيد- عن أن تتناول بالتحليل والنقد والتقويم، أو حتى بالوصف فقط، كل ما جاء في الملف. ولم تتضمن الدراسة أي تقويمٍ كاملٍ لأي بحثٍ من بحوث الملف، واكتفت بمناقشة ما جاء فيها “مناقشةً عامةً”، من جهةٍ، ومناقشةً منظوريةً، من جهةٍ أخرى. وعمومية المناقشة تأتي من كونها مناقشةً لكل بحوث الملف مجتمعةً، من دون أن تكون مناقشةً لأيٍّ من هذه البحوث على حدةٍ. ومنظورية تناول الدراسة للمجلة وملف عددها الأخير أفضت إلى تركيزها على جانبٍ، وإهمال جوانب أخرى قد لا تقل أهميةً منها. لكن هذا هو ثمن كل مقاربةٍ منظوريةٍ. ولا يعني ذلك تقليلًا من مشروعية الرؤية/ المقاربة المنظورية -وكلّ رؤيةٍ/ مقاربةٍ هي، في النهاية، رؤيةٌ/ مقاربةٌ منظوريةٌ- وإنما يعني إقرارًا بحدود تلك الرؤية، وبالحاجة الدائمة إلى تكاملها، وتفاعلها الجدلي الإيجابي، مع المنظورات الأخرى، بعيدًا عن الاستسلام إلى الوهم أو الحلم المغري بإمكانية الوصول إلى المعرفة المطلقة والشاملة، على الطريقة الهيجلية.
ونجرؤ على الزعم بأن المنظور الذي تناولنا من خلاله مجلة قلمون، وملف عددها الأخير، هو (أحد) أهم المنظورات التي يمكن تبنيها في هذا الخصوص والسياق. وتبرز أهمية هذا المنظور، من جهةٍ أولى، من كونه المنظور الذي تعلن مجلة قلمون ذاتها، وبوضوحٍ شديدٍ، تبنيها له وتمثيله لها، بوصفه الأساس الذي تفهم من خلاله ذاتها، ويرتكز عليه عملها ونشاطها. وتظهر أهميته، من جهةٍ ثانيةٍ، من كونه يجسد بعض أهم الإشكاليات النظرية والمشكلات العملية المبحوثة في ميدان العلوم الاجتماعية. ولقد أشرنا إلى تقاطع إشكالية العلاقة بين الثقافة والسياسة مع إشكاليات العلاقات بين المعرفة والأيديولوجيا، بين الموضوع والذات و/ أو الموضوعية والذاتية … إلخ. وتتجلّى أهمية هذا المنظور، من جهةٍ ثالثةٍ، في كونه يكشف عن بعض أهم سمات وجوانب الموضوع المبحوث المتمثل في مجلة قلمون عمومًا، وملف عددها الأخير خصوصًا. ففي سياق دراسة “التفاعل بين الدين والمجتمع (في سورية)”، يبرز، بوضوحٍ وقوةٍ، التوتر بين الثقافي/ المعرفي/ الذاتي والسياسي/ الأيديولوجي/ والموضوعي. والغنى الكبير لهذا المنظور عمومًا، وفي مثل هذه السياقات خصوصًا، كان سببًا في أننا لم نستطع استثمار كل ممكناته المعرفية في دراستنا الحالية، واكتفينا بما رأينا أنه بعض أهمّ المسائل المعبرة عنه وعن الموضوع الذي يتناوله.
مرونةٌ أكبر سياسيًّا/ أيديولوجيًّا، وصرامةٌ أكبر ثقافيًّا/ معرفيًّا، هذا ما نرى أنه ينبغي لمجلة قلمون التفكير في تبنيه مستقبلًا. ففي حين أن الأيديولوجيا/ السياسة التي أعلنت المجلة تبنيها في ممارستها الثقافية/ المعرفية حتى الآن تبدو شديدة الصرامة، يظهر أن المرونة المعرفية التي تتحلى بها المجلة شديدةٌ وزائدةٌ عن الحد. انطلاقًا من ذلك، نعتقد أنه من الأفضل أن تتسم الأيديولوجيا التي تتبناها المجلة بمزيدٍ من المرونة، بحيث تستوعب قدرًا أكبر من التوجهات الأيديولوجية المختلفة. وفي المقابل، نرى ضرورةً كبيرةً في التحلي بقدرٍ أكبر من الصرامة المعرفية، بحيث يرتفع مستوى الحد الأدنى المعرفي للبحوث التي تقبلها المجلة وتنشرها، مع تطوير عمليات تدقيق تلك البحوث ومراجعتها، مضمونًا وشكلًا، معنًى ومبنًى، بما يساعد مجلة قلمون في أن تظل قادرةً على استقطاب/ إنتاج بحوثٍ عالية المستوى، وتعزيز تلك القدرة.
لقد أصبحت “مجلة قلمون” منبرًا سوريًّا مميزًا لامتلاك السوريين لسوريتهم معرفيًّا، وتأسيس تلك السورية والمعرفة معياريًّا، بعد عقودٍ من التصحر، أو بالأحرى عمليات التصحير، إضافة إلى عمليات التفتين، التي مارسها النظام الأسدي، في مثل هذه المجالات. والانهمام السياسي/ الأيديولوجي للمجلة لم يمنعها من الإسهام إيجابًا في الإنتاج المعرفي المفيد، بل كان عمومًا عاملًا مساعدًا في تحقيق ذلك الإسهام/ الإنتاج. فإضافةً إلى الفائدة المعرفية لملف العدد الأخير ببحوثه المختلفة، لا بدّ من الإشارة إلى الوظيفة الأيديولوجية/ المهمة التي قام بها ذلك الملف، من حيث إسهام بحوثه، إلى حدٍّ بعيدٍ، في إزالة السحر عن موضوعٍ فيه كثير من السحر الناتج عن إعمال الخيال والمخيلة، ونقص المعرفة، وسيادة التنميط ومرغوبيته. وبهذا المعنى؛ تكون المجلة قد أسهمت، جزئيًّا ونسبيًّا، في تحقيق أحد (أهم) أهدافها (الثقافية/ السياسية)، والمتمثل في دحض ورفض «ما ينبغي دحضه ورفضه من الأوهام المنبعثة من الماضي أو الماثلة في الحاضر التي يتطلع النظام إلى فرضها على السوريين» (ص 9).
إضافةً إلى أخذ عمليات التصحير المذكورة في الحسبان، نعتقد بضرورة أن يُؤخذ، في الحسبان أيضًا، عمر المجلة القصير، وإمكاناتها المادية، ومواردها أو كوادرها البشرية، في عمليات تقويم المجلة. وإذا كنّا قد أشرنا إلى ضرورة خفض سقف طموحات المجلة وتطلعاتها، لتتناسب مع ما هو ممكنٌ ومعقولٌ؛ فإننا نرى ضرورة أن تُؤخذ في الحسبان حداثة عمر المجلة وإمكاناتها وظروف نشأتها، في تطلعاتنا وتوقعاتنا منها وتقويمنا لها. ولا يعني ذلك القبول بالزعم أنه “ليس في الإمكان أفضل مما كان” وتبرير ما لا يُبرر، أو تقبُّل أو قبول ما لا ينبغي تقبُّله أو قبوله، وإنما يعني ضرورة السعي إلى امتلاك إدراكٍ أكبر وأدق لإنجازات المجلة، خلال تلك الفترة القصيرة الماضية، بما يسمح بامتلاك قدرةٍ أكبر على تقويمها. فبالاستناد إلى مثل هذا الإدراك وذلك التقويم، يمكن فهم سبب استمرار مراهنة كثيرين، ومنهم كاتب هذه السطور، على التطوُّر المستمر لهذه المجلة، على الرغم من كل السلبيات المرافقة لهذا التطور، وبسببها أيضًا. ويمكن النظر إلى هذه الدراسة النقدية على أنها، من جهةٍ أولى، تعبيرٌ عن أمل كاتبها، بل عن توقعه الواثق، في استمرار صيرورة تطوير المجلة، وأنها، من جهةٍ ثانيةٍ، سعيٌ بالغ التواضع والجدية، في الوقت نفسه، إلى الإسهام فيه و/ أو تحفيزه، وإظهار بعض مسوغاته وممكناته وضروراته ووسائله.
(1) يمكن تحميل كل أعداد المجلة الصادرة حتى الآن من صفحة المجلة الموجودة على الرابط التالي: https://www.harmoon.org/magazine/.
(2) يمكن الاطلاع على الورقة الخلفية لملف العدد القادم على الرابط التالي: http://bit.ly/38xDub2.
(3) سنوثِّق، في النص، الاقتباسات والإحالات على العدد الأخير، بوضع رقم الصفحة بين قوسين في نهاية الاقتباس أو الفكرة.
(4) انظر، على سبيل المثال: خوسيه كازانوفا، الأديان العامة في العالم الحديث، ترجمة قسم اللغات الحية والترجمة في جامعة البلمند، مراجعة بولس وهبة، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005).
([5])جمال باروت، يثرب الجديدة. الحركات الإسلامية الراهنة، ط 1، (لندن-بيروت: دار رياض الريس، 1994).
(6) عبد الإله بلقزيز، نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفين، ط2 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2010)، ص 11.
(7) عبد الرزاق عيد، “المثليات جنسيا في الغرب …..و(القبيسيات السحاقيات) في غابات الأسد الإيرانية …!!!”، الحوار المتمدن، العدد 4477، (09.04.2014). https://bit.ly/30mAISe
(8) يذكر موقع “الدُرر السنية“، في هذا الخصوص، ما يلي: “نلاحظ دائمًا أن الدروز لا ينطقون كلمة الصدق بالصاد، إنما ينطقونها ويكتبونها بالسين، وسبب ذلك هو حساب الجمل، فالسين تساوي ستين، والدال تساوي أربعة، والقاف مئة، فيكون المجموع مئة وأربعة وستين هم عدد حدود الدروز، ذلك أن حد الإِمامة تسعة وتسعون (أي أسماء الله الحسنى)، أي أن للإِمام تسعة وتسعين داعيًا، ولكل من الجناح الأيمن والجناح الأيسر ثلاثون داعيًا مجموعهم ستون داعيًا. يضاف إلى ذلك أربعة حدود علوية، فالمجموع الكلي مئة وثلاثة وستون حدًا، يبقى بعد ذلك حد، وهو قائم الزمان حمزة بن علي، ومن هنا نطقوا كلمة صدق ومشتقاتها وكتبوها بالسين حتى تتفق مع حروف الجمل على هذا النحو”. تم الاطلاع عليه في 31.01.2021.
(9) للاطلاع على سياسة النشر، المعتمدة من قبل مجلة قلمون، وإجراءاته وأخلاقياته وطريقة التوثيق، اضغط على التالي.
(10) رابط موقع المدونة: http://abuabdoalbagl.blogspot.com/.
طباعة
مركز حرمون