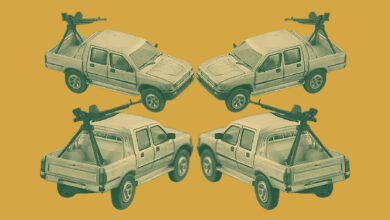جهود العدالة الانتقالية في بلادنا: بناء على رمال متحركة!/ نديم حوري

سيحتاج أيّ مسار عدالة انتقالية اليوم إلى الأخذ في الاعتبار الأذى الذي ارتكبه جناة كثر، من بينهم صدّام حسين ونظامه والاحتلال الأميركي والميليشيات “الشيعية” وتنظيم “داعش”.
يواجه أيّ شخص يهمّه أمر العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمّةً صعبة للغاية: كيف يمكن التعامل مع الماضي فيما الحاضر في حالة اضطراب شديد؟ وكيف يمكن التعامل مع حروب الماضي وانتهاكاته فيما تحدث حروب وانتهاكات جديدة، وأكثر خطورة، اليوم؟ العدالة الانتقالية، عادة، مسارٌ بطيء ومتعرّج يتطلّب الصبر والتخطيط الطويل الأمد، والانتكاسات متوقّعة في خضمّ هذه العملية.
تهدف العدالة الانتقالية إلى ربط الحاضر بماضٍ مضطرب، والسماح للمجتمعات بالشفاء عبر معالجة صدمات الماضي، كما هي الحال في العلاجات النفسية الجيّدة. لكن عملياً، تُبذل أكثرية جهود العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بلدان، لم يحدث فيها انتقال فعلي بعد أو حيث الصراع ما زال مندلعاً.
تُبيّن مقاربة العراق الفاشلة للعدالة الانتقالية بعد عام 2003 مخاطر التعامل مع الماضي من دون معالجة الحاضر. فالسياسات التي اعتُمدت لمعالجة الانتهاكات المُرتكبة في فترة حكم صدّام حسين الدكتاتوري لم تؤد إلى “الشفاء” بل أجّجت جولات جديدة من العنف. فالطريقة التي اعتمدت لتحقيق العدالة، إلى طريقة التعويض على المتضررين، فاقمت المقاربة العراقية الانقسامات وساهمت من غير قصد في نشأة الميليشيات والمجموعات المتطرّفة. وسيحتاج أيّ مسار عدالة انتقالية اليوم إلى الأخذ في الاعتبار الأذى الذي ارتكبه جناة كثر، من بينهم صدّام حسين ونظامه والاحتلال الأميركي والميليشيات “الشيعية” وتنظيم “داعش”.
وتتعقّد مسألة العدالة أكثر في سوريا بسبب “صمود” النظام. وقد اعتمد المجتمع الدولي سياسات عدة لدعم المجموعات التي تعمل بالنيابة عن المحتجَزين والمفقودين في غياهب سجون نظام بشار الأسد. وبعد ظهور “داعش”، انتقل الدعم والاهتمام الدوليَّين ليركّز على انتهاكات “داعش”، ولم يُخصَّص أي جهد لوضع مقاربة متكاملة لمعالجة حاجات الضحايا، بغضّ النظر عمّن ارتكب الجرائم بحقّهم، ليبدو الوضع وكأنّ سوراً صينياً عظيماً يفصل إطارَ عمل العدالة الانتقالية المُستخدم لانتهاكات النظام عن إطار عمل مكافحة الإرهاب المخصّص لانتهاكات “داعش”. بالتالي، لن يحصل أيّ سرد للحقيقة ولن ينال ضحايا “داعش” أيّ أجوبة، علماً أنّ “قوّات سوريا الديموقراطية” المدعومة من الغرب تحتجز آلاف يشتبه بانتمائهم إلى “داعش”، قد يملكون إجابات شافية لعائلات المفقودين.
تهدف العدالة الانتقالية إلى ربط الحاضر بماضٍ مضطرب، والسماح للمجتمعات بالشفاء عبر معالجة صدمات الماضي.
ويكمن تحدٍّ آخر لمسارات العدالة الانتقالية أو مؤسّساتها في فترات الاضطراب في بطئها وعدم قدرتها (هيكلياً أو بيروقراطياً) على الاستجابة بسرعة للأحداث الجارية، وغالباً ما يجعلها ذلك غير فعّالة. فقد حظيت المحكمة الجنائية الدولية بتفويض للتحقيق في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب في ليبيا منذ عام 2011، لكنّها عجزت عن منع الانتهاكات الجارية أو تحويل النقاش نحو المساءلة في البلاد. وحدث أمر مماثل مع المحكمة الخاصة في لبنان بقيادة الأمم المتحدة التي كانت غايتها تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الاغتيالات السياسية في لبنان. فكانت المحكمة بطيئة جداً وتغيّر الوضع في لبنان جدّاً، لدرجة أنّ اهتمام الشعب اللبناني بالمحكمة أصبح شبه معدوم. وحتّى بعدما أصدرت المحكمة الخاصّة بلبنان حكماً بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 18 آب/ أغسطس 2020، لم يكن لها أثرٌ يُذكر على المساءلة.
وتُعتبر الشرعية تحدّياً آخر لآليات تحقيق العدالة الانتقالية في فترات الاضطراب. ففي معظم مقاربات العدالة الانتقالية، تترتّب على الدولة المسؤولية الأساسية في ضمان التعويضات لضحايا الانتهاكات. لكن ماذا لو كانت الدولة في اندثار أو لم تكن لديها شرعية؟ أو كانت قيادتها الراهنة سلطوية وقمعية أكثر من سابقتها؟ فمَن يمتلك سلطة نبش المقابر الجماعية في مناطق تشهد صراعات مثل سوريا أو ليبيا؟ من الأفضل عادة ترك جهود عملية كهذه في يد الدولة. لكن ماذا لو كانت الدولة مشاركة في الصراعات ومن غير المرجّح أن تبذل السلطات الوطنية جهداً من هذا القبيل؟ هل ينبغي على ممارسي العدالة الانتقالية الانخراط مع جهات فاعلة من غير الدولة؟ وإن كان الأمر كذلك، فبحسب أيّ شروط؟ مثلاً هل ينبغي أن يحصل انخراط دوليّ مع السلطات المحلّية بقيادة كردية في شمال شرقي سوريا التي استعادت الأراضي من “داعش”، لكي تتمكّن من المباشرة بنبش المقابر الجماعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها والخوض في مسار من البحث عن الحقيقة وتقديم التعويضات؟ وإن حصل هذا الانخراط الدولي، هل في وسعه المساهمة في جهد وطنيّ مستقبليّ، في حال أُطلق هذا الجهد يوماً ما؟
من الواضح أنّ مسارات العدالة الانتقالية القائمة ببساطة لم تعد كافية.
في حالات أخرى، تتمحور المسألة حول الشرعية: فكلّ مسارات المساءلة أو العدالة الانتقالية للانتهاكات المُرتكبة في عهد مبارك توقّفت في مصر بعدما استلم عبد الفتّاح السيسي مقاليد الحكم. هل من المنطقي ممارسة عدالة انقالية ومساءلة برعاية عهد السيسي الذي برهن حتى الآن أنه أسوأ بأشواط من عهد مبارك؟ في هذه الحالة، ونظراً إلى تضاؤل المساحة السياسية والمدنية وتراجع الحريات العامة، هل ينبغي على ممارسي العدالة الانتقالية البدء بالانخراط بشكل استراتيجي أكثر مع جهود الشتات لسرد الحقائق وتوثيق الارتكابات؟
ما من إجابات سهلة على هذه الأسئلة. لكن من الواضح أنّ مسارات العدالة الانتقالية القائمة ببساطة لم تعد كافية. لذا من الضروري البحث عن مسارات أسرع تمكنها الاستفادة من الفرص السانحة للوصول إلى المساءلة، حتّى لو لم تكن شاملة. ويمكن أن يعني ذلك فتحَ الأرشيف حتّى لو كان التاريخ ما زال قيد الكتابة أو اعتماد آليات لسرد الحقيقة يمكنها الدمج بين الماضي والحاضر. ويمكن أن يعني ذلك أيضاً أنّه ينبغي على ممارسي العدالة الانتقالية أن يصبحوا مرتاحين أكثر إلى الانخراط في مبادرات بقيادة مجموعات جديدة من الشتات وكيانات غير حكومية. وإجمالاً، ينبغي إجراء معاينة نقدية لمقاربات العدالة الانتقالية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في معالجة الإساءات والانتهاكات الكثيرة التي ارتُكبت في الماضي ولا تزال تُرتكب اليوم.
درج