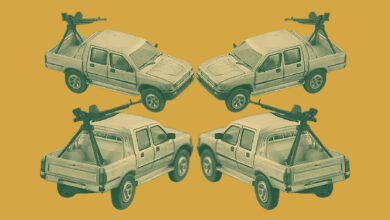الحل السوري ومأسسة الاستبداد والنهب/ حيّان جابر
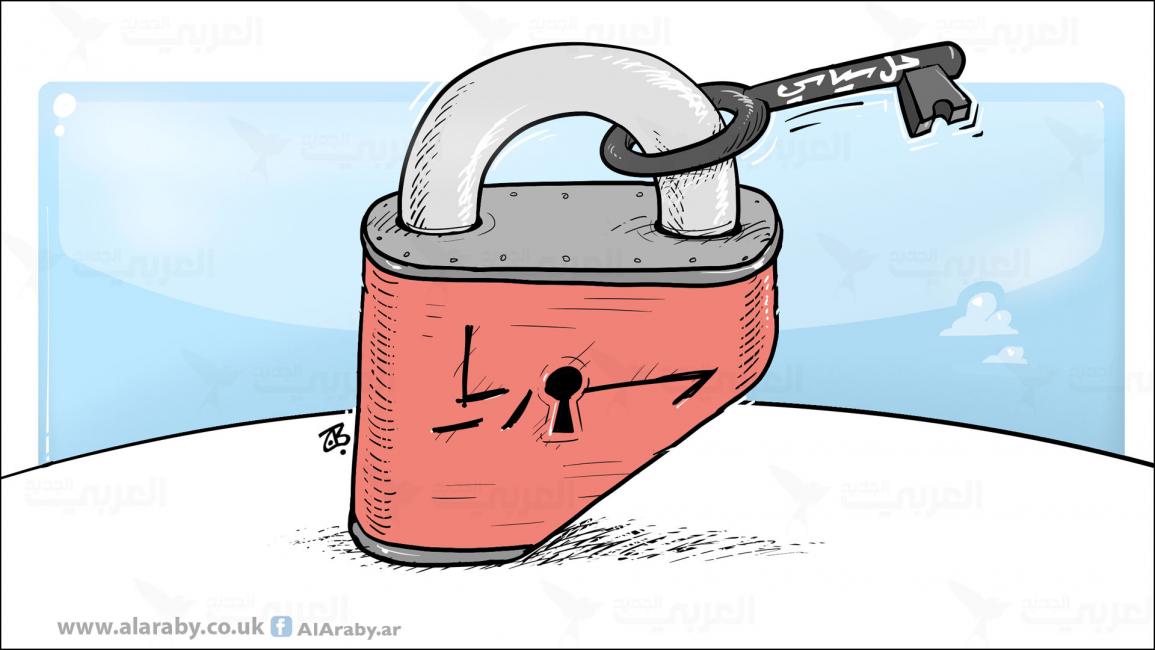
هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية؛ اللجنة الدستورية؛ وفد المعارضة؛ وفد الحكومة السورية؛ الوفد الوطني؛ أستانا؛ سوتشي؛ جنيف، وأسماء وتسميات عديدة تمخضت عنها الجهود الأممية والدولية الساعية إلى حل القضية السورية، على مدار السنوات الماضية، قرابة التسع سنوات، من دون أن يبصر الشارع السوري سبيل الحل، أو يلمس بعض منجزاته الأولية، الأمر الذي دفع عديداً من فئات المجتمع السوري وطبقاته وشرائحه إلى تجاهل هذه اللقاءات كلياً، وتحاشي متابعة أخبارها ومداولاتها، وهي حالةٌ طبيعية لفقدان ثقة الشارع السوري بهذه اللقاءات، وبرُعاتها الأمميين أو الدوليين، كمنظمة الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، وأميركا طبعاً، من دون أن نغفل اهتمام جزء كبير من النخب السورية بهذه الاجتماعات، وكأنها سبيل الخلاص السوري الوحيد، وربما الأوحد، في اعتقادهم.
اعتقد أن الاجتماعات الجارية تحت عنوان حل القضية السورية، منذ بداياتها الأولى في نهاية عام 2011، التي تواصلت وتكثفت في السنوات اللاحقة، لن تفضي إلى تغير نسبي أو جذري يلامس طموحات الشارع السوري الوطني، لكنها ستفضي، لا محالة، إلى تغيّر ما، لكنه تغيرٌ يناقض تطلعات السوريين وأهداف ثورتهم التي تفجّرت في بدايات الـ 2011. لذا، هي لقاءات عبثية من زاوية المصلحة الوطنية السورية، وغير عبثية في ما يخص مصالح القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، لذا تجد نفسك تتفق مع غالبية آراء الشارع السوري التي تتجاهل متابعة حيثياتها وأخبارها، خصوصاً من يعبّر منهم عن رفضها ومقاطعتها وضرورة تجاوزها.
لا تعمل هذه اللقاءات على رسم طريق الانتقال الديمقراطي السوري، بل على العكس، تعمل على رسم طريق مأسسة نظام الاستبداد والنهب القائم في سورية، فهي تهدف إلى تحويل النظام من بنيته الحالية المتمحورة حول الفرد إلى بنيةٍ أكثر ثباتاً وتماسكاً وقدرة على الصمود والبقاء، قائمة على مأسسة النظام الحالي، والحفاظ على جوهرة الاستبدادي النهبي. طبعاً مع ملاحظة دور الاجتماعات أيضاً في ضبط الصراع الدولي على سورية، ومحاولة حسمه بأثمانٍ منخفضة عبر تجنب الصدامات المباشرة طويلة الأمد. حيث يبدو أن استمرار نظام الاستبداد والنهب الحالي المستند إلى أفراد يتناقض مع تطلعات القوى الدولية ومصالحها، قريبة وبعيدة المدى، تماماً كما يتناقض النظام الديمقراطي معها، فالنظام الذي يتوافق مع مصالحها وتطلعاتها يتجسّد في المحافظة على جوهر النظام الاستبدادي والنهبي، مع تحويله إلى عمل مؤسساتي منضبط وغير خاضع لسيطرة ونفوذ وهيمنة شخصياتٍ بعينها، وفي مقدمتها رموز النظام الحاليين كالأسد، كي تتحرّر قوى الاحتلال من مركزية الفرد وتقلباته المضرة بمصالحها، فقد أسهمت مركزية الفرد وسلطته سابقاً في تقويض مصالح بعض القوى الدولية، وفي مقدمتهم الروس والأتراك والفرنسيون، وبدرجة أقل الإيرانيون. وقد طوى الأسد الأب صفحة النفوذ والمصالح الروسية في سورية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، معتبراً أنها فرصة سانحة للتقرّب من المجتمع الدولي والإدارة الأميركية في حينه. وهو ما تكرّر لاحقاً مع الحليف الإيراني في نهايات حقبة الأسد الأب وبدايات حقبة الأسد الابن، عبر القفز من المركب الإيراني إلى المركب التركي في حينه، ليفتح الأسد البلد تماماً أمام الطموحات والمطامع والاستثمارات التركية، من دون أي قيود، بل تماهى الأسد مع السياسة والتوجهات التركية بصورة مطلقة، وصلت إلى درجة استنساخ بعض القوانين التركية كما هي، منها قانون حظر التدخين في الأماكن المغلقة. ومن ثم عاد الأسد الابن عن هذا التحالف، بعد تجاهله النصائح التركية في ما يخص التعامل مع الثورة السورية، ليعود إلى حلفه القديم مع إيران وروسيا، وينقلب على تركيا هذه المرة.
وعليه، التقط نظام الأسد المبنيّ على إمساك الأسد وعصابته الضيقة بجميع مفاصل الحياة السورية، أمنية واقتصادية وسياسية وإعلامية وعسكرية، زمام الأوضاع في سورية، ما مكّنه من قلب الطاولة على حلفائه في اللحظة السانحة دولياً، كانهيار الاتحاد السوفييتي، وتصاعد الخلافات الأميركية الإيرانية، ومن ثم الأميركية التركية، من خلال تحكّم الأسد المطلق والمباشر بجميع ركائز النظام الشمولي، وهو ما منح الأسد مرونةً نادرةً لم تحظَ بها سائر أنظمة المنطقة الاستبدادية المؤسساتية، كالنظام السعودي مثلاً. لذلك، بات من الصعب على قوى الاحتلال الخارجية الفاعلة في سورية، روسية وتركية وإيرانية، التسليم بإخلاص نظام الأسد الشمولي الفردي لهم، مهما بلغ النظام اليوم من ضعفٍ وترهل وربما تفكك.
بالتالي، تتفق الدول التي تحتل الأرض السورية على قاعدتين رئيسيتين: معاداتهم الفجة لأي نظام ديمقراطي سوري حر ومستقل، نظراً إلى تهديده مصالحهم المباشرة على المدى القريب. والانتقال من نظام النهب الاستبدادي فردي الطابع إلى نظام قائم على توازنات معقدة بين مجموعاتٍ متعدّدة من مراكز القوى المتنافسة فيما بينها، على الصعيدين، العام والخاص. يحصل ذلك على مستوى الصراع بين القوى المهيمنة سياسياً، ونظيرتها المهيمنة اقتصادياً، وكذلك بما يخصّ الصراع داخل كل إطار على حدة، كالصراع على السيطرة السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، بل قد نشهد كذلك نوعاً من الصراع الجغرافي على الجهة أو الأطراف المهيمنة على المناطق، كصراع السيطرة على دمشق؛ حلب؛ اللاذقية؛ وغيرها من المدن والبلدات ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، فبهذه الصورة، يتحول النظام الحاكم في سورية إلى أداةٍ طيعةٍ في يد قوى الاحتلال عموماً، والقوة المهيمنة منهم خصوصاً، ما يفقد الأسد وعصابته المسيطرة على سورية، أو ربما التي كانت مسيطرة عليها، قدرتهم على المناورة مستقبلاً، مهما تبدلت الأوضاع والأحوال الدولية.
في النهاية، يبدو من التأجيل المتواصل لحل القضية السورية، حجم الصعوبات التي تعترض طريق المخططات الدولية سابقة الذكر من ناحية، ومدى التنافس الدولي الذي يغذّي مطامح جميع الأطراف في زيادة حصتها من ناحية ثانية، وهو ما يمنحنا مزيداً من الوقت، لإفشال هذه المخطّطات، أو على الأقل عرقلتها عبر استنهاض قوى الشارع السوري، وفق رؤية وطنية وثورية وتحرّرية، تعبّر عن غالبية السوريين المسحوقين والمظلومين والمهمّشين اليوم، لكونها سبيل التحرّر من الهيمنة والسيطرة الدولية، ومسار الانتقال الديمقراطي، وطريق بناء دولة العدالة والحرية والمساواة الوحيد.
العربي الجديد