حين الحال يُكذِّب المقال: رد/ ياسين الحاج صالح + ردود “ثائر ديب”و “ياسين الحاج صالح”
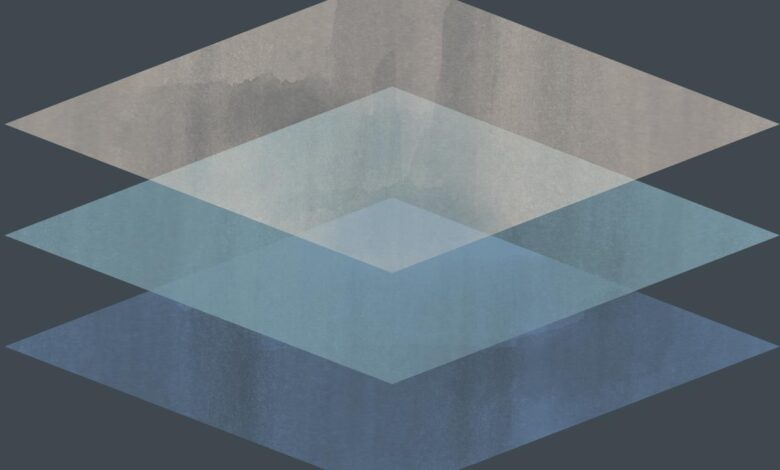
كل المراجع المشار اليها في المقالة، منشورة بعده مباشرة، اضافة إلى رد “ثائر ديب” على المقال
لم أُحصِ عدد المرات التي فاض بها ثائر ديب عليّ بالشتم والتسفيه، لعلها لا تقل عن خمسين خلال عشر سنوات، توزعت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مقالات تكرر الشيء نفسه كل مرة، بنبرة التحريض نفسها، وبشحنة الكراهية نفسها كذلك، ودوماً مع إخراج للموضوع عن السياق، ومع قلة أمانة في الاقتباس. وهو ما تجنبت الرد عليه إلى اليوم. من جهة عملت على تجنب المشاركة في تسميم الجو العام، باعتبار ذلك التزاماً مُعرِّفاً للكاتب والمشتغل بالشؤون العامة؛ ونفوراً مني، من جهة ثانية، من الصورة التي يعطيها كتاب ومثقفون عن أنفسهم ومجال نشاطهم حين ينساقون إلى عداوات موتورة وحروب كلام مديدة، مثل حروب القبائل. والحقيقة أنه كان وراء عدم الرد، فضلاً عما تقدم، ترفعٌ عن مجاراة سَبّاب رقيع، لا يمتنع عن شتم الأب والأم، وعن العنف اللفظي المميز لشبيحة الحكم الأسدي وعناصر مخابراته.
وإذ أرد هنا لأول مرة، فبغرض مخاطبة مهتمين، ربما يميلون إلى تصديق ما يقال بأثر التفاني في تكراره، دون كلل أو ملل.
سأعلق على نقطة واحدة تكررت في مقالة ديب المكرورة هي ذاتها، تتصل بـ «تبرير الإرهاب التكفيري» يفترض أني قمت به، وسأعمل عبر ذلك على إظهار ارتباط ذلك بموقعه ودوره هو في التشكيلة السياسية السورية الراهنة.
في آخر ما وقع بين يدي من رد حيّاته، يورد بين قوسين التالي منسوباً إلي: «لا أزال على موقفي الأول: لا لتبنّي الموقف الأميركي من النصرة، ولا لفتح جبهة صراع معها، طالما كان هذا ممكنًا.. الصراع مع النصرة ثانوي ويعالج بالسياسة، والصراع مع النظام وجودي.. تخوض الثورة معركة صعبة مع النظام، بينما النصرة لا تفتح جبهة ضد أحد في الثورة». هذا «قص ولصق» من المقابلة يهمل السياق الداخلي للكلام. ما ورد في المقابلة التي أجراها معي دارا العبدالله هو التالي:
لا أزال على موقفي الأول: لا لتبني الموقف الأميركي من النصرة، ولا لفتح جبهة صراع معها، طالما كان هذا ممكناً. كنت ذكرت في المادة نفسها [المقالة التي سيأتي الكلام عليها على الفور] أنه يستحيل على المقاتلين على جبهات المواجهة أن يمتنعوا عن التعاون مع النصرة، دع عنك أن يواجهوها، وأنّ من شأن قبول الموقف الأميركي توريد صراع إلى قلب القوى التي تقاتل النظام، وهو ما يناسب النظام وحده. ومن معاينة الواقع على الأرض في غير منطقة، بعد كتابة المقالة بشهور، يبدو لي هذا صحيحاً تماماً.
الإجابة تُحيل إلى مقالة نشرتها في مطلع العام نفسه، تعلق على إدراج الأميركيين لجبهة النصرة في قائمة المنظمات الإرهابية، وورد فيها ترتيب للخيارات السياسية وقتها، ليس على النحو التقريري في الاقتباس المزور فوق، بل على النحو التالي:
(1) اعتبار الصراع مع النظام أساسياً ووجودياً، ومع النصرة ثانوياً، ويُعالج بالسياسة؛ (2) اعتبار الصراع مع النصرة أساسياً مثل الصراع مع النظام، وخوض صراعين في آن معاً؛ (3) اعتبار الصراع مع النصرة هو الأساسي والوجودي، والصراع مع النظام ثانوي، ويعالج بالسياسة.
وبدا لي وقتها أن الخيار الأول هو «ما يبدو متوافقا مع الثورة، وما تسير وفقاً له اليوم». أضفتُ إنه «حين تختلف الظروف، كأن يسقط النظام أو تنقلب النصرة إلى مواجهة مجموعات المقاومة المسلحة الأخرى، يتغير التقييم والموقف». وهو ما التزمت به لاحقاً، وما يفيد بأن الأمر يتعلق بـ«تقدير موقف» محدد. هذا واضح في المقابلة نفسها بالمناسبة. فقد ورد فيها: «نتكلّم من مواقع وأوضاع محددة، وفي إطار سياسي وتاريخي متغير وكثيف التغيرات، وما نقوله اليوم قد نقول ما يغايره بعد حين، أو ما يناقضه. هذا طبيعي. ولا أَعِدُ شخصياً بغير المثابرة عليه».
أما ما يخص عدم خوض جبهة النصرة صراعاً مع أحد، فقد ورد قبل ما تلاه في اقتباس ديب، وليس بعده، وبالصيغة التالية: «والشيء الثاني [الأول هو الاعتراض على التوافق مع الموقف الأميركي] هو الاعتراض على فتح معركة جانبية مع جبهة النصرة، بينما تخوض الثورة معركة صعبة مع النظام، وبينما النصرة لا تفتح جبهة ضد أحد في الثورة».
وعدا قلة الأمانة في الاقتباس، هناك إغفال للسياق الخارجي، أو حقل الصراع الجاري في البلد وقتها. المقالة كُتبت ونُشرت في مطلع 2013، في سياق حرب النظام المفتوحة على الثورة وتصاعد المواجهة المسلحة ضده وخروج مناطق متسعة من سيطرته، يعيش فيها جمهور كان معرضاً للحصار والقصف اليومي، بما في ذلك قصف طوابير الخبز، ومع مثابرة النظام على رفض أي حلول سياسية تتضمن التنازل ولو عن 2 بالمئة من السلطة على نحو يجنب البلد أسوأ المخاطر (قلت ذلك في المقابلة التي يحيل إليها بمستوى أمانته المعهود).
يتعلق الأمر في كل حال بتحليل لأوضاع بعينها، وليس بمعتقد لا يتغير، أو بـ«تبرير للإرهاب التكفيري»، على ما استطاع مُطبِّع الإرهاب الأسدي أن يقول. ما يمكن أخذه، وما آخذه أنا، على تناولي في المقالة هو الركون إلى منطق تعبوي ضيق، يصدر عن فكرة «التناقض الرئيسي»، ويقوم على التضاد، فيضيق في المحصلة حقل الرؤية السياسية. جدير بالذكر أنه نشرت لي بعد أيام من المقالة المعنية مقالة أخرى تتناول الموضوع نفسه، ليس من زاوية سياسية هذه المرة، بل من زاوية اجتماعية وثقافية، في محاولة للإجابة على سؤال ما هي مشكلتنا مع جبهة النصرة؟.
والمقالة تنتهي بالسطور التالية:
من جهتنا لا نرى أنه يمكن مواجهة «جبهة النصرة» بالهروب وإشاعة التشاؤم، ولا بالنقد الليبرالي، ولا بالوعظ الوطني والعلماني. يمكن مواجهتها، ويجب، بجبهة اجتماعية سياسية قوية، تتطلع إلى أوسع انخراط للسوريين في الحياة العامة لبلدهم. ملايين السوريين الناشطين سياسياً هم القوة الأمنع أمام مصادرة الثورة لأي طرف سياسي أو ديني.
وحده ما هو جيد في مواجهة نظام الطغيان هو الجيد لمواجهة «جبهة النصرة» وأشباهها.
المقالتان كُتبتا في الوقت نفسه، ونُشرتا في الجمهورية بفارق أسبوع واحد بينهما. وبطبيعة الحال لن يجد من يعتمد على ديب في معلوماته إشارة للثانية. إذ لسنا هنا حيال نقد يعمل على قول الحقيقة، بل أمام معركة غير أمينة تحفزها ضغينة متجددة وغرضها التشويه.
ومن أجل إضاءة الموضوع، سأعرج على معركة مماثلة يكرر خوضها المجاهد ضد «تبرير الإرهاب التكفيري» (المحب بالمناسبة لحزب الله ولدولة الولي الفقيه في إيران التي يجاهر الحزب المذكور بتبعيته لها). يتعلق الأمر بـ«أطروحة الصفر الاستعماري التي طلع بها في تسعينيات القرن الماضي اليساري السابق رياض الترك» بحسبه. ليس صحيحاً، بداية، أن الأطروحة المزعومة تنحدر إلينا من تسعينات القرن الماضي (الرجل كان في سجن حافظ الأسد حتى أيار 1998). الواقع أن الترك سُئل من مراسل أجنبي بُعيد الاحتلال الأميركي للعراق في نيسان 2003 عن تقييمه لما جرى، فقال إن العراق كان تحت الصفر تحت حكم صدام، وأنه الآن في الصفر بعد إسقاط نظامه، وأن ما قد يرفعه فوق الصفر هو ما يفعل العراقيون بالتحول الذي جرى في بلدهم. لا يتعلق الأمر بـ«أطروحة» عن الاستعمار إذاً، بل بتعليق ظرفي له سياق بالغ التحديد، يمكن التحفظ عليه (التعليق) كثيراً أو قليلاً، لكنه يبقى تفاعلاً مع أوضاع بعينها في سياق بعينه. ثم إنه جرى تكرار الكلام على «أطروحة الصفر الاستعماري»، وفي قول آخر «نظرية الصفر الاستعماري»، ربما مئات المرات، من أشباه ديب ممن يُحتمَل أنهم صدقوا الكذبة لفرط ما كرروها (ومعلوم أن قصب السبق في هذا التقليد للنازيين)، تماماً مثلما يكرر ديب اجترار «تبرير الإرهاب التكفيري» منسوباً إلي.
عواطف ديب المعادية للاستعمار لا تشمل بطبيعة الحال روسيا وإيران وميليشياتها الطائفية المجلوبة من لبنان والعراق وأفغانستان. ما لدينا هنا ليس موقفاً مبدئياً من أي نوع، بل حصراً تطوع لتسفيه معارضي النظام الجذريين. وهذا ممن يتلجلج اللجلجة كلها في قول جملة مفيدة واحدة عن النظام الذي قتل محكوميه بالتعذيب والسلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة، والذي له تاريخ في اعتقال وتعذيب معارضيه، والذي بعد ذلك يحكم سوريا منذ أكثر من نصف قرن. الواقع أن ديب، الذي سبق أن قضى أربع سنوات في سجن النظام، يعرف كيف يكرّ اللازمة التي تقول إن النظام هو المسؤول الأساسي، فقط كي يتبعها فوراً بلكن… تفرغها من أي مضمون. وخلال ما ينوف على عقد من الثورة والحرب في سوريا، وطوال سنوات قبلها، لم يكرس ولو مقالة صغيرة واحدة عن هذا «المسؤول الأساسي»، تقول شيئاً واضحاً بشأنه. ما يثير أشد انفعاله ويدفعه للكتابة ليس صور المعذبين في ملف قيصر مثلاً، ليس صور الدمار بالبراميل المتفجرة، ليس كذب بشار الأسد في شأن البراميل والتعذيب، ليس تطييف الدولة، ليس إفساد وظيفتها القمعية بالذات، ليس الشبيحة وتأليه بشار وأخيه ماهر، ليس النظام المسؤول عن تسعين بالمئة من فوق نصف مليون من الضحايا (داعش والنصرة وجميع الآخرين أقل من 10 بالمئة)، ليس حصار درعا وتجويع أهلها، ليس حرق جثث من قتلهم النظام تحت التعذيب وطمرها في مواقع مجهولة، بل مقالة لي وأطروحة مزعومة لرياض الترك وربما تصريح لبرهان غليون، مع تكرار غوبلزي لهذا «الربرتوار» طوال الوقت.
فإذا جرى الاعتماد على ديب لتكوين فكرة عن سورية خلال عقد، استخلص المُعتمِد أن النظام وأجهزته ربما يكونان مشكلة من مشكلات سورية، لكن هناك مشكلات أكبر وتستحق النفير المستمر، منها مثلاً مقالة لي أو مقابلة، أو بوست على فيسبوك. فإذا كان ما يكتبه الواحد منا يعبر عن الوزن النسبي للقضايا التي تنال اهتمامه، ولذلك يكتب في بعضها كثيراً وفي بعضها أقل، كان من المفترض بـ«معارض وطني ديمقراطي» للحكم الأسدي أن يكتب عن تكوين هذا النظام وسجله التاريخي وبنية المصالح التي يرعاها وتعريف المجموعات التي تصعد في ظله وأولوياته العليا وهياكله السياسية والجهازية، ونوعية روابطه الإقليمية والدولية، وصولاً إلى عرضه البلد على أجانب مقابل حماية ملكه… لكن هذا غاب كلياً عن تقارير ديب المكرورة. يفترض المرء كذلك أن الصراعات المُعَرِّفة لواحد منا، أي المُشكِّلة لهويته الفكرية ككاتب، هي تلك الأشد حضوراً في كتاباته. فإن صح ذلك، كان الصراع المُعرِّف لديب هو الصراع ضد أمثال الداعي، وكان «الآخر»، وبالأحرى العدو، الذي يعرف نفسه بالتقابل الضدي معه هو أنا وآخرين، وكانت اللازمة الطقسية الخاصة بأن النظام هو المسؤول الأساسي، لكن… هي تعويذة الضمير الآثم ضد تشكك محتمل بأنه في واقع الأمر موالٍ خجول.
قد يجري التذرع بأن الموقف من النظام معروف، فلا داعي لقول المزيد بشأنه، فلا يقال بالفعل شيء. وهكذا يصير النظام مجهولاً أكثر بحجة أنه معروف سلفاً، ويجري تطبيع عنفه وعنف حُماته فلا يعود مرئياً، ويتم إغراق المساحة الأكبر من واقع سورية في الظلام. الأمر على كل حال لا يتعلق بـ«الموقف» حصراً، بل بتحليل يتجدد ولا يكف عن استكشاف أوجه من التكوين السياسي السوري، مما ليس صحيحاً بحال أنه معروف كفاية. وليس صحيحاً بعد أن موقف المذكور معروف حتى كموقف. الموقف السياسي والأخلاقي للواحد منا ليس شأناً من شؤون القلب أو علاقة خاصة بينه وبين ربِّه، مقرها أعماق النفس. يُعرف موقف الكاتب من كتابته، وتعرف هوية الكاتب الفكرية والسياسية والأخلاقية من نتاجه المنشور لا من غيره، فأين هو النص الواحد للكاتب الذي يقول لنا ما تركيب هذا النظام الذي قتل مئات الألوف من محكوميه، ودعا أجانب توسعيين لمشاركته وليمة القتل؟ وأين هي الهوية اليسارية لكاتب لم يكتب صفحة واحدة، مخصصة لمن يحكمون بلده منذ نصف قرن، بينما هو لا يقوم بأي عمل عام غير الكتابة؟ وما هو الفرق في النتاج بين الكاتب الذي لا يكتب عن أَولى ما يفترض به أن يكتب في شأنه وبين «كاتب التقارير» للمخابرات مثلاً؟ معلوم أن كاتب التقارير يستهدف حصراً معارضي النظام بوشاياته. والحال أن منبع الكذب الدائم هو بالضبط هنا: الفاعل الأكبر وشبه الأوحد في تاريخ البلد خلال نصف قرن غير مُمثَّل في كتابة مَن عمله الكتابة. بالمقابل، شعر صاحب «الموقف المعروف» من النظام أن عليه أن يجتر ما قاله عني عشرات المرات على الأقل، وليس في الأفق بعد ما يشير إلى أن «الموقف» مني ومن آخرين صار معروفاً كفاية. الأرجح أن طقس العبادة المقلوب هذا مستمر… «إلى الأبد».
أو قد يجري التذرع بأن ديب يقيم في البلد، وينبغي أن يكون مفهوماً أنه لا يستطيع أن يسمي أشياء كثيرة بأسمائها. يمكن التعاطف مع هذه الحجة، لكن جزئياً فقط لأن المرء لا يَعدم طرقاً للتعبير عن موقعه واصطفافه الحقيقي. هذا، حتى لو لم نقل إنه في مواجهة أزمة وطنية هي الأكبر في تاريخ سورية خلال قرن ونيف لا يجب أن يحول حائل دون قول بعض الحقيقة للناس إن تعذر قولها كلها، وهذا تحت طائلة ألا تقال الحقيقة أبداً. فضلاً كذلك عن اعتبار أخلاقي يقضي بأن من لا يستطيع تسمية أشياء بأسمائها يستطيع على الأقل ألا يسميها بغير أسمائها، وأن يُكرِّم المرء صمته الاضطراري عمّن يخشاهم بأن لا يتطوع طوال الوقت لتسفيه من لا يخشاهم. هذا من أجل ألا يكون المتطوع جلاداً رمزياً، يثابر على جلد أعداء النظام دون غيرهم، مكملاً عمل جلادي الأجساد من المخابرات الأسدية، وإن ربما متحسراً على أنه ليس في متناوله أجساد يجلدها. وفي هذا الشأن، لعله يمكن فهم التكرار الذي لا ينتهي كرغبة في التجسيد، كسعي وراء أجساد لا تُطال.
ينبغي فهم دور هذا الجلاد الرمزي كمساهمة واعية في الصراع الاجتماعي والسياسي والفكري في سورية والمنطقة، مساهمة تدرج عنف النظام، التعذيب والاغتصاب والبراميل والكيماوي والمجازر ضمن المتوقع والمألوف، الذي لا حاجة إلى الكلام عليه بالتالي، ما يعني عملياً تطبيع هذا العنف الإبادي كما تقدم. وهي مساهمة لا تقارب حتى «الإرهاب التكفيري» إلا من زاوية التحريض على «اليسار المتلبرل» أو «يسار جبهة النصرة»، فلا تنظر في جذور الإرهاب ذاك السياسية والاجتماعية والفكرية، المحلية والدولية، مما يفترض أن ينهض به المثقف اليساري، ولا تُسائل مفهوم الإرهاب ذاته عن شرعيته، ولا من باب أولى تستكشف العلاقة بينه وبين إرهاب الدولة المُخصخصة والمُطيّفة، المسكوت عنه برضا. عمل الجلاد الرمزي هو التعذيب الرمزي، وليس إنتاج معرفة بالواقع السوري. ومن هذا الموقع الثورة السورية ذاتها لم تحدث، وهي ليست محفزاً لتفكير يتجدد، لإعادة نظر في أدوات التحليل ومناهج العمل، ولتفكير متجدد في الأهداف، لإعادة تعريف الذات. بدل توسيع دوائر ما يُكتب في شأنه، يجري تضييقها فتصير كالزنازين. وما كان يقال من قبل يقال هو نفسه من بعد، فلا تاريخية ولا تاريخ، ولا قطيعة ولا إعادة هيكلة. وهذا المستنقع الراكد من ابتذال فكري وأخلاقي، ومن نصوص- زنازين، ومن التكرار واللاتاريخية، فضلاً عن عُصابية متوترة ومكيودة، هو ما يشهد لنفسه بأنه اليسار الصحيح. التشكيلة السياسية الأسدية، المهجوسة بدوامها الخاص أو بتكرار نفسها إلى الأبد، تحتمل دور مُكرِّرٍ يكره من تكره ويضع الثورة ضدها بين قوسين، وتُرحب بتقاريره الباسلة.
في الختام، الحقيقة التي لم تقل إلى اليوم لن تقال يوماً، والكذب الذي استمر إلى اليوم مستمر حتى الموت. ديب موال للقوى الحامية للنظام ومعارض لمعارضي النظام، وبهذه الصفة حاله يكذب مقاله، وموقعه الفعلي يكذب موقفه المُدّعى. تكراره العبدي لحفلة الجلد الرمزي نفسها مرة تلو المرة يؤشر على انفعال عدائي سلبي يستبد به، وسواس قهري قدير يمنعه من أن ينفصل عن مكروهيه، بل يوقعه في حب كرهه لهم، فيثابر على الصلاة لهذا الكُره الحبيب طوال الوقت. وإذ صار ديناً على هذا النحو، يحول الكره بين هذا العبد المؤمن وبين أن يستقل عن الأشرار من أمثالنا فكرياً وسياسياً وأخلاقياً، أي أن يتشكل كذات مستقلة، تنتج الأفكار وتوسع نطاقات المعنى، فتحرر نفسها بعملها هذا. عبد التكرار لا يناضل لا من أجل الديمقراطية ولا من أجل قضية تحررية عامة. قضيته هي استئناف رمزي لعمل الجلادين الأسديين، وشرط صلاحيته هو دوام التشكيلة الأسدية. تنتهي التشكيلة فتنتهي الصلاحية فوراً.
موقع الجمهورية
———————————-
اليسار السوري خلال العقد الأخير وبعده/ ثائر ديب
يصعب أن نتصوّر، في المدى المنظور على الأقلّ، يسارًا سوريًّا ثوريًّا ذا وجه مستقل، يقوم بالدور الذي يُنتظَر أن يقوم به يسار يستحقّ هذا الاسم، وذلك لجملة متراكبة من الأسباب. فطوال أكثر من نصف قرن، تعرّض اليسار السوري الجدير بهذا الاسم لحملات قمع وحشي متلاحقة ومتسارعة لم تسمح ببناء جدّي لكوادره أو قواعده أو برامجه. وأتى انهيار “الكتلة الاشتراكية” في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وأوائل تسعينياته، لتجري كتل كبيرة من هذا اليسار مع الطَّفو الليبرالي الرائج متنكرةً لأبسط مبادئ تاريخها السابق. وأتت بعد ذلك انتفاضة الشعب السوري، ليرتكب فيها هذا اليسار السوري المتلبرل أشنع الأخطاء، بل الجرائم، السياسية.
عند تناول اليسار السوري بعد العقد الأخير، لا بدّ من التنبيه منذ البداية إلى أمرين ضروريين لن ندخل هنا في نقاشهما: الأول، هو أنّه مهما تكن أخطاء وجرائم اليسار السوري والمعارضة السورية عمومًا، فإنّهما ليسا السبب في ما جرى للبلد. ومشكلتهما، ومشكلتنا معهما، أنّهما لم يكونا حلًّا أو بديلًا أو فاعلًا يحسن الفعل، لا أنهما علّة ما جرى، فالعلّة معروفة لا تستحق أدنى نقاش في كونها العلّة البنيوية الجوهرية. والثاني، هو أنَّ الأساس الاجتماعي أو الطبقي الذي تنهض عليه هشاشة اليسار السوري على مختلف الصّعد إنّما هو هامشية هذا اليسار. والمقصود بالهامشية هو الارتباط الواهي بالطبقات والفئات الاجتماعية ومصالحها والانعزال الاجتماعي الاقتصادي عن السيرورات الجارية، نظرًا لاحتلال الكتلة الأكبر من هذا اليسار مواقع هامشية ضمن بنية البلد، سواء بسبب الأعمار المتقدمة أو الفتيّة (الطلاب خصوصًا)، أو بسبب الوظائف والمواقع، أو بسبب ما تركته اعتقالات سابقة من آثار التخلّع الشخصي والاجتماعي، أو بسبب الارتباط – المستجدّ – ببنى وسياقات خارج البلد.
كانت الانتفاضة التي انطلقت في سوريا في عام 2011 واحدًا من ارتدادات الزلزال البادئ في تونس ثمَّ في مصر وليبيا واليمن وصولًا إلى سوريا، على نحوٍ يذكّر بعض الشيء بثورات عام 1848 التي اكتسحت أوروبا متنقلةً من بلد إلى بلد. لكنَّ سوريا تميّزت عن تلك البلدان بأمور حاسمة، منها: تغييب احتكار السلطة والقمع المديد كلَّ مظهر جدّي من مظاهر المجتمع المدني (أحزاب، نقابات، جمعيات، نوادي، صحافة مستقلة، قضاء مستقل.. إلخ)؛ والتحام الجيش التحامًا وثيقًا بقمّة السلطة؛ وتمكّن قبضة النظام الأمنية على مدى عقود من إسكات الشعب وكسر عظام المعارضة؛ وموقع سوريا الجيوسياسي الإقليمي والدولي وعلاقتها الوثيقة بالقضية الفلسطينية؛ وبنية النظام الصلدة العاجزة عن احتمال أدنى اختلاف.
ساهمت في الانتفاضة بدايةً شتّى الفئات الاجتماعية والتيارات السياسية والفكرية، وغلب على أشهرها الأولى طابع التظاهر السلمي الذي تمكّن، على الرغم من القمع الوحشي، من أن يخلق ما تدعوه سوسيولوجيا الثورات بـ”الوضع الثوري”: حيث يرفض المحكومون أن يُحكَموا بالوسائل السابقة، ويعجز الحاكمون بوسائلهم تلك عن إبقاء الوضع على ما كان عليه، وتتزعزع بأفعالٍ على الأرض علاقةُ الإخضاع التي تربط الطرفين، وتتركّز شتى التناقضات في المستوى السياسي على شكل أزمة سياسية يحاول النظام حلّها لا بالقمع وحده، بل أيضًا بالاعتراف بأنّ ما يجري سياسيّ وبالدعوة إلى الحوار أو التفاوض وبتغيير الحكومات والقوانين والدساتير والبرلمانات، بما يخلق احتمال أن تتحوّل مثل هذه التغييرات شيئًا فشيئًا، على وقع انتفاضة الشارع، من مجرّد تغييرات شكليّة زائفة بقصد الانحناء أمام العاصفة إلى لحظة تحوّلٍ حاسمة.
لم تكد التظاهرات السلمية تضع قدم النظام على أوّل هذه الطريق حتى أدّى القمع الوحشي والتمويل والتسليح الخارجي (لا سيما الأميركي والتركي والخليجي) وتزايد نفوذ تيارات الإسلام السياسي وحلفائه من اليساريين السابقين المتلبرلين في المعارضة إلى طغيان الطابع المسلّح وتحوّل الانتفاضة إلى حرب مدمرة اختلط فيها المحلي بالإقليمي والدولي، وأفسحت المجال لتسيّد الإرهاب التكفيري من “نصرة” و”داعش” وأشباههما، لتتوارى في الخلف الأقسام الأوسع من الشعب السوري ومطالبه المحقّة المزمنة في الحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون. ولم تعد الثورة ثورةً، لا من حيث الطبيعة الاجتماعية والسياسية لفئاتها القائدة، ولا من حيث الأهداف التي تتوخّاها، وهما الأمران اللذان عادةً ما تتعرّف بهما الثورات.
لم يكن اليسار السوري عمومًا بالغائب عن الحراك، على الرغم من الطابع الشعبي غير الحزبي الذي غلب في المراحل السلمية الأولى، وعلى الرغم من الضعف البنيوي الذي يعاني منه هذا اليسار بعد عقود القمع والاعتقال المديدة وتمزّقه الحاسم (بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج الثانية) بين أربعة تيارات: تيار وطني ديمقراطي ماركسي، سيعبّر عن نفسه بعد الانتفاضة من خلال “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، كما من خلال أشكال جمعية وفردية مستقلة أخرى؛ وتيار ليبرالي جديد، سيعبّر عن نفسه من خلال “المجلس الوطني السوري” ثم “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”؛ وتيار شيوعي تقليدي مرتبط بالنظام من خلال “الجبهة الوطنية التقدمية”؛ وأعداد كبيرة من اليساريين المستقلين من شتى الآراء. كان لليسار، على الرغم من ضعفه، حضوره في الحراك، كما كان له الوزن المعنوي الذي فرض نفسه على تيارات الإسلام السياسي وداعميه ومموليه وتجلّى في مسائل عديدة أبرزها تعاقب ثلاثة من اليساريين السابقين المتلبرلين على رئاسة “المجلس الوطني” (برهان غليون وعبد الباسط سيدا وجورج صبرا).
شكّلت المراهنة على التصاعد التدريجي لنضالات السوريين وعلى نبذ السلاح والتدخّل الخارجي والطائفية محور سياسات اليسار الوطني الديمقراطي المنضوي في “هيئة التنسيق” والشخصيات المستقلة القريبة منه. ومثّل هؤلاء مشروعًا لـ”التغيير الوطني الديمقراطي” لطالما كان المساهمة النظرية والنضالية الكبرى التي قدّمها الوطنيون الديمقراطيون واليساريون السوريون وأَنْمُوهَا على مدى عقود منذ أواخر ستينيات القرن الماضي إلى الآن. ويجمع هذا المشروع بين التشديد على ضرورة التغيير الجذري الذي ينقل البلد من الاستبداد إلى دولة القانون والحريات السياسية كشرط لا بدّ منه للانتقال من التخلّف الاقتصادي الاجتماعي إلى التقدّم والعدل، وبين معرفةٍ ببنية البلد ونظامه وموقعه الجيوسياسي تسبغ على ذلك التغيير الجذري صفات الوعي بالمخاطر المحتملة، وبين إدراك لأهمية المسألة الوطنية والقومية وعدم انفكاكها عن المسألتين الديمقراطية والاجتماعية في بلد مثل سوريا.
تمثّلت هذه الرؤية خلال الحراك في التشديد على أنَّ الخلاص من الاستبداد الفاسد إمّا أن يكون خلاصًا وطنيًّا ديمقراطيًّا أو لا يكون؛ وأنّ ميزان القوى وطبيعة النظام يقتضيان أن يكون هذا الخلاص سيرورة متصاعدة تتلاقى فيها المقاومة المدنية السلمية والعمل السياسي، والعفوية والوعي، وحماس الشباب وخبرة الشيوخ، في جولات متلاحقة تحتمل الفشل والتراجع، لا بسبب قوة الطرف الآخر فحسب، بل أيضًا درءًا للمخاطر الأسوأ التي رأينا بالفعل كيف دُفِعَت سوريا على سكّتها بكلّ توحّش وفقدان للبصيرة.
لذلك لم ينبهر أصحاب هذا المشروع ببعض الأساطير التي راجت وتقدّست مع انطلاق الانتفاضات العربية مثل “العفوية” و”الشباب” و”ضرر التنظيم والسياسة”. وانتبهوا إلى أنّ أقسامًا من المعارضة ليست معنيّة بالحرية والكرامة بقدر عنايتها بتغيير تحالفات سورية الإقليمية والدولية. ووعوا أهمية توحّد المعارضة على خطّ وطني ديمقراطي، الأمر الذي تجلّى في ما دُعي “اتفاق القاهرة” في أواخر عام 2011 الذي ساهم في صوغه القيادي اليساري البارز عبد العزيز الخيّر ووقّعه كلّ من هيثم منّاع عن “الهيئة” وبرهان غليون عن “المجلس الوطني”، لكن غليون ما لبث أن سحب توقيعه بأمر من ممولي “المجلس” ورعاته.
بيد أنّ “الهيئة” ذاتها – في ظلّ اختطاف قيادييها البارزين عبد العزيز الخيّر ورجاء الناصر ونزوح كثير من عناصرها باتجاه من حسبوه منتصرًا – لم تبق على تمسّكها السابق بخطّها الوطني الديمقراطي، الأمر الذي تجلّى في مشاركتها الخانعة في “الهيئة العليا للتفاوض” إلى جانب “الائتلاف” ومسؤولين سابقين في النظام منشقّين وفصائل مسلحة عديدة، ما أضعف كثيرًا تمثيلها الخط الوطني الديمقراطي.
تَمَثَّلَ الجناح “اليساري” الآخر بعدد من القوى والشخصيات التي كانت يسارية وتحولت إلى الليبرالية و/أو الشعبوية ودخلت “المجلس الوطني” وخليفته “الائتلاف” إلى جانب، بل تحت، الإسلام السياسي (ممثلًا بالإخوان المسلمين بصورة أساسية). ويكاد هذا “اليسار” أن يكون مقلوب “يسار النّظام” ووجه عملته الآخر. ويكفي أن نعرف أعداء النّظام في كلّ فترة، كائنًا من كان هؤلاء الأعداء، كي نعلم من هم محطّ إعجاب هذا “اليسار” في تلك الفترة، وصولًا إلى إعجابه بالجيوش الأميركية المحتلة أو المستعدة للاحتلال، كما نجد في أطروحة “الصفر الاستعماري” التي طلع بها في تسعينيات القرن الماضي اليساري السابق رياض الترك (القائد التاريخي للحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي الذي غيّر اسمه إلى “حزب الشعب الديمقراطي السوري”). ومفاد هذه الأطروحة أنّ الاستعمار يعيد بلداننا إلى الصفر الذي أنزلها الاستبداد تحته، وأنَّ الخلاص من الاحتلال الخارجي الاستعماري أسهل من الخلاص من الاستعمار الداخلي الذي تمثّله الأنظمة المستبدة.
لم يُلاق هذا “اليسار” الأخير الحراكَ العفوي في 2011 بأيّ برامج أو تصورات تحسب حساب توازن القوى والأخطار المحتملة، بل لاقاه بأردأ أنواع الشعبوية التي تعزف على آلام القتل الوحشي وجراحه. بدا الأمر آنذاك كأنّه فرصة لا تتكرر، يقتنصها هؤلاء ولو خرب العالم. وحين صعب اقتناص الفرصة، حبّذ هذا “اليسار” لا العنف المعارض فحسب، بل قسمة الجيش والعلَم والبلد، والتدخل الخارجي، والطائفية. ومع ازدياد القمع وتسيّد حركات إرهابية تكفيرية ليست “داعش” و”النصرة” سوى مثاليها الأبرز، كشف هذا “اليسار” عن وجه ظلاميّ عبثي رهيب لا يتردد في تبرير الإرهاب التكفيري وفي اعتبار ما يستولي عليه من أرض أرضًا “محررة”، من دون أن يجرؤ على دخولها. يقول عضو “حزب الشعب” جورج صبرا في محضر اجتماع “المجلس الوطني” بتاريخ 20 و21 آب 2013: “إننا في المجلس الوطني لم نعلن لا تصريحًا ولا تلميحًا ضد جبهة النصرة أو غيرها، وقد دافعنا في اجتماعنا مع الأميركان دفاعًا قويًّا عن جبهة النصرة، كما لم تدافع هي عن نفسها”. ويقول ياسين الحاج صالح، العضو السابق في الحزب ذاته والذي اشتهر بلقب “حكيم الثورة”، في مقابلة معه في جريدة المستقبل اللبنانية في 6 تشرين الأول 2013: “لا أزال على موقفي الأول: لا لتبنّي الموقف الأميركي من النصرة، ولا لفتح جبهة صراع معها، طالما كان هذا ممكنًا.. الصراع مع النصرة ثانوي ويعالج بالسياسة، والصراع مع النظام وجودي.. تخوض الثورة معركة صعبة مع النظام، بينما النصرة لا تفتح جبهة ضد أحد في الثورة”. وقوله هنا لا يقتصر، بالطبع، على موقف هذا الكاتب من “النصرة”، ولا على ثمرة صراعاته الثانوية والوجودية التي نراها أمامنا، بل تتعدّاهما إلى فكرته عن الجبهات وحسبانه أنّه وأمثاله كان يمكن، في اللحظة والسياق المعنيين، أن تكون لهم جبهتهم بين الجبهات.
يبقى الإنجاز الفريد لهؤلاء تطويرهم أطروحة “الصفر الاستعماري” إلى تحالف فعلي مع ضواري العالم الاستعماري (لا سيما أميركا وإنكلترا وفرنسا ونواطير نفطهم في الخليج)، ودعوة هؤلاء إلى التدخل العسكري وإنزال ضربات عنيفة بالبلد (الذي يطابقون بينه وبين النظام). وفي حين كان وهم الحريات والديمقراطية والتنمية لا يزال يظهر مع الطبعة الأصلية لأطروحة “الصفر الاستعماري” مثل ورقة توت تغطي عورتها، سقطت هذه الورقة تماماً عن النسخة المطورة لتبدو على حقيقتها العارية من أيّ مطامح ما عدا الانتقام وإرواء الغليل، الأمر الذي يتجلى في عدم تفريق هؤلاء بين مطار أو مركز للبحوث وبين النظام، كما يتجلّي في افتقارهم إلى كلّ خطاب ما عدا خطاب التضرّع إلى رؤساء أميركا (بل وإلى إسرائيل) وتوسّل ضرباتهما ولومهما على التقصير فيها.
في مطلع العام 2017، بعد 6 سنوات من طوفان الدم والخراب، اعترف عدد كبير من أبناء هذا التيّار، في وثيقة موسومة “نداء إلى شعبنا السوري: من أجل الحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية، وجهة نظر نقدية لتصحيح مسارات الثورة السورية”، بأنهم اقترفوا “أخطاءً” و”أوهامًا” جسيمة، كما دعوها، من بينها وهم المراهنة على “أن نوعًا من التدخّل الدولي سيحصل”، و”التعويل على الخارج والارتهان لأجنداته”، و”وهم المراهنة على “جبهة النصرة.. وأخواتها”؛ و”وهم المناطق المحرّرة”؛ و”وهم المراهنة على الكيانات والخطابات الأيديولوجية والطائفية”؛ وسواها من الأوهام التي “ثبت أنها كلها تصدر عن عقليات قدرية ورغبوية لا علاقة لها بالسياسة ولا بموازين القوى، ولا تبدي أي حساسية للأرواح والتضحيات ولا للأثمان الباهظة المدفوعة ولا لعذابات شعبنا”. لكن حبر هذا البيان الذي كُتب في ظلّ نوع من العزوف الأميركي والغربي عن الاهتمام بالوضع السوري، لم يكد يجفّ حتى عاد هؤلاء إلى التطبيل لا لضرب ترامب مطار الشعيرات ثم مركز البحوث فحسب، بل لضربات إسرائيل المتكررة أيضًا.
تعيش سوريا اليوم وضعًا رهيبًا تعوم فيه على خراب هائل وعلى مئات آلاف الضحايا وملايين المشردين من دون أن تتقدّم قيد أنملة على طريق التحول الديمقراطي الذي كان من المفترض باليسار أن يكون حامله الأبرز الذي ينتزعه من أيدي دعاته الزائفين من الضواري الإمبرياليين بجمعه مع المطلبين الوطني والاجتماعي، وبإضفاء طابع العدالة الاجتماعية والاقتصادية والاستقلال الوطني على الصراع من أجل الحرية والديمقراطية. غير أنّنا لو دققنا فسنجد أنّه ليس لدى اليسار السوري الحالي، بكتلته الغالبة، بل وليس لدى الإنتيليجنسيا السورية والمثقفين السوريين عمومًا، أيّ مشاريع نظرية وفكرية جادّة ومفصّلة، فما بالك بالمشاريع السياسية والعملية، على هذا الصعيد. بل إننا لا نكاد نجد دراسات ذات قيمة عن بنية البلد الاجتماعية الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية وتاريخ تكوّنها. ولا نكاد نجد حتى أعمالًا أدبية عليها القيمة عن سوريا ومحنتها. جلّ ما نجده شعارات ومطالب سياسية تُحسَب خطأً أنّها رؤى فكرية. حتى الأطروحة السياسية الأهمّ لدى هذا التيار، “التغيير الوطني الديمقراطي”، ببعد نظرها وإدراكها تكوين البلد وتناقضاته وتوازن قواه، سرعان ما كانت تُرمى جانبًا كلّما لوّح لهؤلاء أحد، سواء كان النظام نفسه أم خصومه.
إذا ما كان معروفًا عن اليسار وعن الإنتيليجنسيا عمومًا أنّهما بعيدان عن شعبوية عموم المثقفين، لا يتنازلان عن معرفتهما العلمية برغم انحيازهما للقيم الديمقراطية ومصالح الناس، فإنّ اليسار السوري والمثقفين السوريين يبدون انتقالًا سريعًا ومفاجئًا من احتقار الشعب الصامت إلى تقديس الشعب الصارخ، من الدعوة العجيبة إلى العمل الثقافي البعيد عن السياسة حينًا إلى الانخراط السياسي التام لإسقاط النظام ثم إلى الفرار حتى من المناطق التي سقط فيها حينًا آخر. هكذا انتقل هؤلاء من مديح الأنظمة البرجوازية الصغيرة القومية غير النقدي حتى أواسط سبعينيات القرن العشرين إلى اعتبار التمرد الإسلامي المحدود عليها أوائل الثمانينيات حركة شعبية تلفّ سورية من أقصاها إلى أقصاها. وبدوا في 2011 كأنّهم يحولون “الشباب” إلى أسطورة. والتحقوا بمشروع الإخوان المسلمين وامتدحوا حتى “النصرة” و”داعش” من دون أي انتقاد إلا بعد فوات الأوان ومن منطلق الخندق الواحد. وطالبوا بتدخّل حلفائهم الخارجيين (أميركا وأوروبا والخليج وتركيا) من دون أيّ تبرير نظري يتعدّى مظالم النظام وخزعبلات شعبوية مفادها أنّهم لا يسمحون لأنفسهم بأن يتعالوا على “الحراك” أو بأن يطالبوا “الشعب” بغير ما يفعله.
يكمن تفسير جزء كبير من الدور الذي لعبه المثقفون السوريون واليسار السوري في تاريخ سوريا الاجتماعي الثقافي وموقعهم فيه على أساس الانشقاق غير الحاد بينهم وبين النظام السياسي لفترة طويلة، وحصوله، حين حصل، على نحو مترع بالأخطاء وأسواء الفهم، وعلى أساس الالتحاق بعد ذلك بمشاريع سياسية مناقضة لمشروعهم الديمقراطي، إسلامية غالبًا، والانخراط في تصوير هذه المشاريع على أنّها مشاريع شعبية بغية تغييب كلّ نقد جدي لها على غرار تغييب كلّ نقد جدي للشعب الثائر.
هذه التبعية لمشاريع أخرى، سلطوية وإسلامية، تفاقمت في العقود الأخيرة بتحوّل عالمي أطاح بدور المثقفين النقدي والأخلاقي لمصلحة فكر ليبرالي ضامر يركّز تركيزًا قاصرًا على حقوق الإنسان، ويفهم العدالة فهمًا ضحلًا وفوضويًّا، ويُحِلُّ الناشطَ محلّ المناضل، والمنظمات غير الحكومية المتمولة والمرتبطة محلّ أحزاب المناضلين ونقاباتهم، ويحتفي بصعود التيارات الهوياتية الطائفية والقوموية الشعبوية ذلك الاحتفاء المجرم.
هذه هي الظروف الكارثية العامة والخاصة التي يتعيّن فيها على يسار سوري أن ينهض إذا ما أراد النهوض واستطاع إلى ذلك سبيلًا، بتصورات جديدة، وآليات عمل جديدة، وربما ببنى جديدة، بل وبأجساد وعقول جديدة بالمعنى الحرفي للكلمة.
[هذه المقالة جزء من طاولة مستديرة خصّصتها جدلية لتناول موضوع اليسار في سوريا، وهي مقالة رأي ولا تعبّر بالضرورة عن آراء جدلية].
————————–
حوار مع ياسين الحاج صالح الثورة السورية دفاع عن الحياة قبل الخبز والحرّية
حاوره دارا عبدالله
إشكاليَّة خطابه وجديَّته ودقَّته، هي التي دفعتني لإثارة هذا النقاش مع الكاتب السوري ياسين الحاج صالح. المثير في خطاب ياسين بالضبط، هو تناوله لكلّ القضايا الشائكة والصّعبة في الشّأن السوري بجرأةٍ حادَّة، بعيدة تماماً عن كليشيَّهيات « الحياء الوطني » و »التعفُّف المعرفي »، ياسين يحاول كَسر حواجز التقيَّة الدلاليَّة التي انتشرت بكثرةٍ في الخطاب السياسي والفكري السوري، تلك التقيَّة التي شكَّلت فُصاماً بين الشفوي المنطوق في السر والمكتوب المُقرُّ بهِ في العلن. بمعنى آخر، ياسين يكتب تماماً ما يفكّر به تماماً، لا نقاشات خاصَّة ولا كلام لا يُقال
(دارا عبدالله ـ ألمانيا)
[ برأيك ما هي الأسباب الرئيسيَّة وراءَ انطِلاق الثورات في العالم العربي بشكلٍ عام والثّورة السوريَّة بشكلٍ خاص، هل هي طبقيَّة اقتصاديَّة، أم سياسيَّة حقوقيَّة؟ بمعنىً آخر، هل هذه الثورات هي ثورات خُبز أم ثورات حريَّة؟
ـ إذا فرقنا بين وعي الفاعلين والمشاركين في الثورة، عند انطلاقها بخاصة، وبين ما يحتمل أن يكون بحثا مُترويا فيها، نحصل على صورتين مختلفتين. من وجهة نظر المشاركين تظهر أكثر أسباب مباشرة، تحيل إلى ما هو سياسي وحقوقي، لكن ربما تظهر أمام نظر ة متروية محركات اجتماعية أكثر خفاء وأطول أمدا. في بداية الثورة السورية كان يجري الكلام أكثر على اعتقال أطفال درعا ومعاملة ذويهم، وعلى الاعتقال السياسي عموما، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، وعلى المهانة التي يعانيها السوريون من قبل أجهزة الأمن وعلى حكم الحزب الواحد….إلخ. في وقت لاحق، تطورت مقاربات أكثر تعقيدا، تنظر في التحول نحو اقتصاد السوق، في تهميش الأرياف وضواحي المدن وأحيائها الطرفية، في تكوّن طبقة جديدة ملتحمة بالسلطة وفاحشة الثراء، وفي كون النظام السياسي ووحشيته حاضنة لضرب من التراكم الأولي لا يختلف في شيء عن الاستعمار
وعدا أن هذا بدوره ليس الكلمة الأخيرة في شرح الثورة، لسنا في سوريا حيال مجتمع متشكِّل، تتمايز فيه منازل السياسة والحق والإيديولوجية والاقتصاد. نظام الاستثناء البعثي والأسدي كان الإطار الذي تشكلت فيه الطبقة الجديدة، التي لذلك بالذات لا تملك أي كمون ديموقراطي، بل التي عرضت كمونا فاشيا كبيرا أثناء الثورة. الحرمان من الحرية يجعلك عاجزاً عن الاحتجاج حين يخلو بيتك من الخبز، وغير قادر على الإضراب أو التعاون مع أشباهك في عمل عام. فهل يكون الحرمان من الحرية مسألة حرية فحسب؟
وحين تُقصف طوابير الواقفين أمام أفران الخبز بالطائرات، هل ذلك قمعٌ للحرية، أم هو حرمان من الخبز؟ أليس تدميراً للحياة، بالأحرى؟
وحين يجري تجويع المعتقلين الذين يتعرضون لتعذيب وحشي في مقرات الأمن الفاشية، ويموت بعضهم من الجوع والمرض، هل هذا حرمان من الحرية أم تجويع من الخبز؟
أليس بالأحرى تدميراً للحياة، تدميراً الشروط الحياة البشرية ولإمكانية أن تكون سورية بلداً يعيش الناس فيه معاً؟
وما يتعيّن استخلاصه أن الثورة دفاع عن الحياة، قبل أن تكون طلبا للحرية أو للخبز
وبعد أكثر من عامين ونصف يبدو لي أننا حيال عملية إعادة تشكل تاريخية واسعة، تطال الدولة (كياناً ومؤسسة حكم) والدين والمجتمع والسكان، وتفيض كثيرا على الثنائية المُضمّنة في السؤال
[ في ورقةٍ طويلةٍ لك بعنوان « صُعود العدميَّة المقاتلة في سوريا »، مُستوى التحليل فيها فكري ويدورُ في حقل الثقافة والمجتمع، تقول: « التيَّارات العدميَّة لها قابليَّة اختراق مميَّزة من قبل أجهزة الاستخبارات »، وهذا الكلام أتّفق معك به تماماً، وينطبق على الكثير من العدميَّات المقاتلة التي ذكرتَ بعضها في الورقة المنشورة. وفي مقال آخر لكَ نُشر في « موقع الجمهورية للدراسات » بعنوان « في شأن جبهة النصرة والسياسة الملائمة تجاهها »، مستوى التحليل فيها سياسي مباشر، تقولُ فيها: »الصراع مع النظام أساسي ووجودي، ومع النصرة ثانوي، ويعالج بالسياسة »، وترى هذا الخيار « متوافقاً مع الثورة »، السؤال يكمن عن التناقض بين رؤية فكريَّة ترى في التيارات العدميَّة مداخل لأجهزة المخابرات، ورؤية سياسيَّة ترى الصراع مع تيار عدمي كجبهة النصرة يُفترَض أن يكون مُخترقاً من أجهزة الاستخبارات حسب الرؤية الأولى، « أمر ثانوي ويعالج بالسياسة »، وكيف نقول لا سياسة مع النظام ونقبل السياسة مع أدواته؟
ـ دعني أوضح السياق المخصوص للمادة الثانية، في شأن جبهة النصرة…، وهي مكتوبة ومنشورة في الشهر الأول من هذا العام. كانت المقالة تعترض على شيئين. أولاً على دعوات إلى التوافق مع الأميركيين في شأن اعتبار جبهة النصرة تنظيماً إرهابياً ومواجهته، ومعلوم أن ممثلين « للائتلاف الوطني » وجدوا حينها أنهم غير قادرين على تحمل تبعات الموقف الأميركي واعترضوا عليه. وأعتقد أنهم كانوا على حق. الشيء الثاني هو الاعتراض على فتح معركة جانبية مع جبهة النصرة، بينما تخوض الثورة معركة صعبة مع النظام، وبينما النصرة لا تفتح جبهة ضد أحد في الثورة. قلت في المقالة: « حين تختلف الظروف، كأن يسقط النظام أو تنقلب النصرة إلى مواجهة مجموعات المقاومة المسلحة الأخرى، يتغير التقييم والموقف »
يتعلق الأمر في كل حال بتحديد أولويات، مما لا يستغني عنه أي تفكير سياسي، وليس بانحيازات فكرية أو عقدية. أفترض أن الأمر لا يحتاج إلى توضيح، وأن قراءة المقالة نفسها أفضل من السماع عنها. هذا عنوان الموقع
http://therepublicgs.net/
وكي أزيد الأمر سوءاً، أعترف بأنني بعد أكثر من ثمانية شهور على نشر المقالة، لا أزال على موقفي الأول: لا لتبني الموقف الأميركي من النصرة، ولا لفتح جبهة صراع معها، طالما كان هذا ممكناً. كنت ذكرت في المادة نفسها أنه يستحيل على المقاتلين على جبهات المواجهة أن يمتنعوا عن التعاون مع النصرة، دع عنك أن يواجهوها، وأنّ من شأن قبول الموقف الأميركي توريد صراع إلى قلب القوى التي تقاتل النظام، وهو ما يناسب النظام وحده. ومن معاينة الواقع على الأرض في غير منطقة، بعد كتابة المقالة بشهور، يبدو لي هذا صحيحا تماماً.
وأرى أنك تقوم بقفزة استدلالية غير وجيهة حين تستخلص من مبدأ قابلية المنظمات العدمية للاختراق المخابراتي، وهو ما قلتُه في « صعود العدمية المقاتلة… »، إلى أن « المنظمة العدمية » التي هي « جبهة النصرة » مخترقة مخابراتياً، وهي تالياً أداة للنظام السوري. القابلية لشيء لا تعني وقوعه حتماً، وحتى وقوع اختراق لا يعني أن الجهة المخترَقة أداة للجهة المخترِقة
وأجد مضيئا جداً التساؤل عن كيف نقول لا للسياسة مع النظام، ونعم مع أدواته
ترى متى فُتح باب السياسة؟ هل فتح النظام في أي يوم باب التفاوض مع محكوميه؟ بحدود ما أعلم أنه هو من بادر بالحرب، وهو المستمر فيها، وهو الذي لم يتوقف عن القتل منذ أكثر من 900 يوم، وهو الذي لم يظهر أدنى استعداد للتنازل عن 2% من سلطته لأي كان؛ هو نفسه الذي كان سياسيّا جداً مع كل من هم أقوى منه
ومن باب تقليب الأمر على وجوهٍ قد تظهر بعض المضمرات، من المشروع التساؤل: كيف يرْفض السياسة مع التابع، النصرة، من يريدونها مع السيّد، النظام؟
بالمناسبة، ما جرى اقتباسه في السؤال، عن أن الصراع مع النصرة ثانوي ويعالج بالسياسة، والصراع مع النظام وجودي، لم يأت بالصورة التقريرية الواردة في السؤال، بل في صورة عرض لاحتمالات ثلاثة، كي نتبيَّن أيّها الأكثر ملاءمة
ووقت كتابة المقالة، لم تكن في بالي تطورات وقعت لاحقاً، وبخاصة ظهور « الدولة الإسلامية في العراق والشام » (داعش)، والتمايز الحادث بينها وبين النصرة، بخاصة من حيث أن أكثر « المهاجرين » تحولوا إلى « داعش »، بينما تعرض النصرة وجها سورياً أكثر. أفترض أن أي طرف سياسي سوري سيأخذ علما بهذا التمايز، ويُفترَض أن لا يخص قوتين غير متماثلتين بالسياسة نفسها
لكن يبدو أن هذا التساؤل يندرج ضمن صنف من الخطابات الدارجة في سوريا، اليوم والأمس، تتعامل مع الآراء والتقديرات المرتبطة بسياقات زمنية وسياسية محددة كأنها عقائد ثابتة وغير زمنية، ووفقا لمنطق ثنائي القيمة، بحيث تكون أي ظاهرة تاريخية، جبهة النصرة في سياقنا، إما « دح » أو « كخ »، وإذا لم تشتمها وتردح ضدها، فأنت إذن معها أو محاب لها. هذا مسلك « طائفي »، يفيد في بناء مُعسكر أو عصبة ضد معكسر أو عصبة، وليس في فهم أو شرح أي شيء. نتكلّم من مواقع وأوضاع محددة، وفي إطار سياسي وتاريخي متغير وكثيف التغيرات، وما نقوله اليوم قد نقول ما يغايره بعد حين، أو ما يناقضه. هذا طبيعي. ولا أعِدُ شخصياً بغير المثابرة عليه
[ تنتشرُ في تحليلات بعض النقّاد بأنَّ الإسلام السوري هو إسلام وسطي ومُعتدل، وبأنَّ « تنظيم القاعدة » هو جسم غريبٌ طُبق من فوق على المجتمع السوري، برأيك إلى حد هذه المقولة دقيقة مع العلم أن كثيراً من المقاتلين الجهاديين في العراق كانوا سوريين، وهل المجتمع السوري لديه آليات ذاتية خاصة به تقاوم تطرف « تنظيم القاعدة »؟
ـ على افتراض أن تدينه أصلاً وسطي ومعتدل، لا يبقى المجتمع السوري بالمزاج نفسه مهما تكن الأحوال والأهوال التي يواجهها. تعرضت قطاعات واسعة من المجتمع السوري، بيئات سنية أكثر من غيرها، لاقتلاع عنيف، ونُزِعت إنسانية ما لا يعد من الناس. لديك نحو ثلث السكان اضطروا لهجر مواطنهم، ومليونين خارج البلد، ومئات الألوف اعتقلوا وعذبوا بحقد، ودمّرت بيئات الحياة في عشرات المناطق خارج البلد، ولم تحمِ السوريين المنكشفين لا رابطة وطنية محليّة ولا قواعد وقوى دولية
لا تستطيع أن تنزع إنسانية الناس، ثم تتوقّع ألا تخرج من دواخلهم وحوش وأشباح متنوعة، أن يبقوا أناساً رائقين مبتسمين، لا يحرّكون ساكناً قبل التفكير بآثاره على… « الوحدة الوطنية ».
توفرت بيئة أنسب لمنظّمة القاعدة في بلدان تعرضت للتحطيم، أفغانستان تحت الاحتلال السوفييتي، والعراق تحت الاحتلال الأميركي، وسوريا تحت الاحتلال الأسدي. هذا ينتج عدداً كبيراً من الناس الغاضبين الذين لديهم شعور شديد بالظلم، ويرون العدالة في صفهم لأنهم مظلومون. وهم أيضا أناس لا يثقون بأحد، لا بالمعارضة ولا بالغرب ولا بالمؤسَّسات الدوليَّة، وأعتقد أن لديهم كل الحق في ذلك. في الوقت نفسه جرى تحطيم أية قوى تحرُّرية على يد المحتلين أو الطغيان، فلم تبق إلا النبتات الصحرواية التي تستطيع العيش مهما تكن ظروف البيئة قاسية بفعل اعتيادها قسوة البيئة وعمق جذورها. في المقام الثالث لدينا فكر ديني إسلامي، تطبيقي وتشريعي وأوامري، مسكون بخيال الامبراطورية التي تشكلت أصوله في ظلها. ثم هناك خميرة قريبة نشطة، تتمثل في القاعدة في العراق، وكان للنظام الأسدي « أياد بيضاء » في تنميتها وتوفير سبل الحياة والاستمرار لها
توفرت في الثورة السورية فرص كبيرة ولوقت كافٍ لتلاقي الشروط الأساسية الأربعة: الوحشية ونزع إنسانية ملايين + اللاثقة الجذرية + الفكر الأصولي المتشدد + الخميرة تفضّل، إليك غول مكتمل الملامح
الآن، الدروب التي كانت سالكة من الشام إلى العراق صارت سالكة من العراق إلى الشام. هل كان يمكن ألا تنعكس الدروب؟ أن يواصل الغول الأسدي اللعب بغول عدمي صغير في العراق، وغويل آخر في لبنان، دون أن تكبر الغيلان الصغيرة، وتبدأ بالانقضاض عليه، عندما تتاح الفرصة. الطرفان يكرهان بعضهما كراهية مميتة، وكانا يعرفان جيّداً أنهما يلعبان معاً لمصلحة مشتركة عارضة.
واليوم، الدروب المطروقة صارت اليوم إقليماً مفتوحاً، عراقياً شامياً، ينتشر فيه الغول « داعش »
ما هو العنصر الديناميكي والمُفعِّل لهذا المُركَّب الغولي؟ وحشية النظام الأسدي المستمرة دون ريب. لا يمكن فعل شيء في وجه غول القاعدة، من دون التخلص من الغول الأسدي. كل يوم إضافي من عمر هذا النظام يحمل قوة وتمكنا أكبر للغول الآخر. ولا ريب عندي أن هذا الغول الأخير سيفترس نظيره إن استطاع، أو ربما يتقاتل الغولان إلى أن يحطما سوريا نهائياً.
[ برأيك إلى أيّ حد يستطيع السجين السياسي السابق التحرُّر من مخزون الألم الهائل في الذاكرة أثناء التحليل السياسي أو الفكري في الشأن السوري، وهل تعتقد أن الذاكرة المرضوضة الموجودة في اللاوعي سوف تترك النظرة في هدوئها ودقِّتها وتوازنها المعرفيَّ؟ وإلى أيِّ حد ياسين يستطيع المراقب والمحلل للثورة السورية أن يخلق التوازن بين الانحياز الأخلاقي المطلق للثورة السورية والبرودة التحليليَّة اللازمة؟
ـ لطيف جدا
اسمح لي بالتعامل مع السؤال، والأسئلة الأخرى، كنماذج لخطاب غير شخصي، يحاول الإيحاء بأنه « متوازن » و »دقيق »… لكنه يحمل في الواقع الكثير من السياسة والمواقف السياسية الخاصة. أحاول خلخلة هذا الخطاب، وإظهار محمولاته السياسيَّة، مع التهكّم اللازم
لا أعرف كيف يُعرَف إن كان « السجين السياسي السابق » قد « تحرر » من « مخزون الألم الهائل ». وإذا كانت « الذاكرة المرضوضة » موجودة في « اللاوعي »، فكيف لي أن أعي ما تفعل! هل يحتمل لهذه الذاكرة أن تترك « النظرة » بسلام، دون أن تقض مضجع « هدوئها ودقتها وتوازنها المعرفي »؟ لا أعرفُ أيضاً. هل ترشدني إلى عينة من النظرات « الهادئة الدقيقة المتوازنة معرفيا » كي أستطيع المقارنة والحكم؟
طيب، أظن أن واقعة إني سجنت طويلا مؤثرة حتماً في توجهاتي الفكرية والسياسية. لكن هل تفسّر هذه الواقعة انحيازي للثورة وعدائي للنظام؟ وهل تقول عن « التحليل السياسي أو الفكري في الشأن السوري » الذي أقوم به شيئاً مغايراً جداً عما قد يقال عن « التحليل السياسي والفكري » لآخرين لم يُسجنوا، أو سجنوا واستطاعوا بطريقة ما التحرّر من « مخزون الألم الهائل »؟
عدا أني كنت معارضا حين اعتقلت قبل عقود، يبدو لي أن هذا النوع من النقاش يضمر أني وأمثالي معادون للنظام بسبب أحقادنا الذاتية، وليس لدينا قضية عامة عادلة فعلاً. أدعُ جانباً أن اعتقال الألوف وعشرات الألوف (وقتل مثلهم) في زمن سبق، ليس مجرد شأن ذاتي لهؤلاء الألوف، وأنه قضيّة عامة ووطنية، وأتساءل: لماذا يتوجب على سوري معارض تقديم ثبوتيَّات خاصة لإقناع أيٍ كان بأنه « هادئ ودقيق ومتوزان معرفياً »؟ ولماذا يبدو أن السوريين الأكثر جذريَّة في معارضة النظام هم بالتحديد المطالبون بالقيام بمثل هذا الفحص النفسي؟ ألمجرد التأكد من عدالتنا، ونحن نتكلم على شؤون البلد الذي قتل فيه حتى اليوم 120 ألف إنسان، وقُصِفَت الناس بالطائرات، وصورايخ السكود، والأسلحة الكيماوية؟
قد يفترض ملاحظ خارجي أنه يتعين، بالأحرى، فحص نفوس وضمائر من سكتوا على الجريمة المستمرة، أو التمسوا للقاتل الأعذار، أو تخصصوا في لفت الأنظار إلى تفصيل هنا وتفصيل هناك، بما فيها ما يقوله عن الجريمة أمثالي وكيف يقولونه!
لكن لا. هذا اللغو الطبي المنحول عن رضوض الذاكرة واللاوعي، والألم الهائل، والهدوء والدقة والتوازن، هو خطاب طرف واعٍ جداً، يهمُّه أن يظهرك شاهداً غير ثقة على المذبحة لأنه لا يريد أن يقال شيء عن المذبحة. من وراء مظهره العلمي المتجرد، غرض هذا الخطاب هو نزع الشرعية عن المنحازين للثورة بذريعة الافتقار للهدوء الدقة والتوازن، وإن كان يتفهم أسباب ذلك. يضع أصحاب الخطاب أنفسهم في موقع علمي مزعوم متعالٍ على الشهود من أمثالنا، لحجب وقوفهم في صف القاتل. ويبدو أنه يسوؤهم بخاصة التعبير المباشر عن السخط الأخلاقي. هذا « شعبوية ». كلمات مثل مجرم وقاتل لا تليق بالعقول المتوازنة، خصوصا حين تكون في وصف معسكر النظام
ولغرض نزع الشرعية عنّا لا يناسب خطاب مبني على آراء وتقديرات وشهادات حية، يمكن التيقن من صدقها الواقعي وموافقتها « طبائع العمران » الأسدية (قصف الغوطة بالسلاح الكيماوي مثلاً، وقد شكَّك فيه، وشوَّش عليه بالضبط أمثال أصحاب هذا الخطاب). يلزم خطاب العلم لإظهار علاقة لا تكافؤ جذرية بين أقوال أطباء المجتمع والسياسة المتوازنين، الدقيقين والهادئين أيضا مثل « الدكتور » بشار الأسد، وأقوال شهود ومتابعين يحملون رضوضاً غائرة في لاوعيهم، بما يشكك في سلامة أحكامهم، وفي توازنهم المعرفي، من أمثالنا.
أعتقد أنه لو كان الأمر بيد هذا الصنف « المتوازن » من الناس لأحالونا إلى مصحات عقلية. الفاشية تتأسس بالضبط على خطابات ذاتية الصواب كهذه، وليس على شهادات وتحليلات جزئية
في حقيقته هذا خطاب كيماوي، إن جاز التعبير، خطاب إبادة، غرضه خنق الشهود العامين على نحو ما خنق الغاز السام الناس في الغوطة وغيرها. ولا أعتقد أني أسيء الظن بالقول إن أصحاب هذا الخطاب يفضلون لو اختنقت أصواتنا. ما أعرفه من عينات مشابهة لهذا الخطاب ينطوي على كراهية ضارية لا ترتوي، وبعض عيناته تعادل تحريضاً مباشراً على القتل
ولا أعرف بعد ذلك ما هي درجة الحرارة المناسبة للتفكير المتوازن، أريد عموماً أن أكون بارد التفكير وحار الوجدان. ولا أدري ما هو رأي أطباء الذاكرات المرضوضة بالتوازن الحراري الحاصل
لكن حين يسمي أولئك الأطباء المجرم باسمه، وحين تحرج ضمائرهم وقائع قصف أفران الخبز بالطائرات والأحياء بصواريخ سكود والنيام بالسلاح الكيماوي، أكثر من تسمية القاتل قاتلاً والمجرم العام مجرماً عاماً، عندها ربما نتكلم في شؤون « التوازن »، و »الهدوء » و »الدقة » أيضاً
جماعة النظام الصرحاء أكثر استقامة، بالمناسبة، من أصحاب هذا الخطاب. كانوا يقولون لنا بكل بساطة: أنتم حاقدون! غرضهم أيضا أنه ليس لنا قضية عامة وعادلة، لكن يقولونها دون لف ودوران، دون خطاب طبي ركيك، ودون رطانة الذاكرة المرضوضة واللاوعي والتوازن المعرفي
[ مع موجة « الضربة » الأميركيَّة المُفترضة ضد النظام السوري، وإبداء الرأي العام الغربي بشقيَّة الأوروبي والأميركي حساسيَّة ضعيفة تجاه قضية عادلة كقضية السوريين، مع العلم أن رفض التدخل كان يتم وفق برلمانات منتخبة واستطلاعات رأي ديموقراطية وشفافة، وليس عبر مراكز استخبارات ومؤسسات حكم. إلى أي حد تتحمل المعارضة السياسة السورية مسؤولية هذا؟ وهل يكفي تحميل المسؤولية للغرب وشتمه ووصفه بأنَّه إلى جانب النظام السوري؟
ـ لا يكفي تماما شتم الغرب وتحميله المسؤولية ووصفه بأنه إلى جانب النظام السوري، لكن لا بأس به، ولا أحد يتضرر منه
لم توجه قوى غربية ضربة للنظام السوري لأنها في الأصل غير راغبة في ذلك، وجاء استعداد النظام لتسليم السلاح الكيماوي يحررها من حرج الاضطرار لمعاقبة مجرم طائش، تجاوز حدوداً مرسومة. الجماعة لديهم رأي عام مضاد للتدخلات الخارجية بسبب المردود السلبي لآخر التدخلات، وأوضاعهم الاقتصادية المتعثرة. وحتى لو تفوّقت المعارضة السورية على نفسها في عرض قضيتنا، لما تحقّق لها في تقديري تعديل كبير في الموقف في الغرب. كان مهما أن يحقق معارضون سوريون اختراقات، ولو محدودة، في التواصل مع المجتمعات الغربية من باب التمرُّس بمخاطبة الرأي العام هناك، وعدم البقاء أسرى مناجاة أنفسنا واجترار إحساسنا بالعدالة الذاتية وظلم الغير. لكن ما كان لهذا أن يقلب الوضع لصالحنا في تصوُّري
ما كان يمكن أن يقلب الوضع هو وجود مصلحة مباشرة للقوى الغربية للتدخل. كانت قادرة على تعبئة الرأي العام في اتّجاه أكثر تقبُّلا للتدخُّل لو كانت لها مصلحة فيه. ربما تعرف أن نسبة أعلى من الرأي العام الأميركي، قاستها « استطلاعات رأي ديموقراطية وشفافة »، صارت مع ضربة للنظام السوري خلال الأيام القليلة التي بدا أن الإدارة الأميركية تعتزم فعلاً ضرب النظام. ظلت النسبة أقل من نسبة المعترضين، لكنها تكفي للقول إن فتور الرأي العام الأميركي يقبل التغيير بقدر ما. كانت الرسالة المضمنة في إحالة أوباما قرار الضربة إلى الكونغرس، وهو قادر على أخذ القرار دون العودة إلى الكونغرس، أنه متردد في أمر الضربة، وهو ما يثبت الرأي العام في موقع معارض لها
وقبل أن تبدأ بالتراجع احتمالات الضربة الأميركية كان رأيي أن ضرب النظام السوري لمجرد أنه قتل محكوميه بالسلاح الكمياوي شيء أعدل، وأكثر إنسانية وتقدمية، من أن يكون دافعاً أميركياً كافياً لمعاقبة النظام السوري
أيا يكن الأمر، لا يسعف في فهم الأحوال السورية واتّخاذ موقف عادل بشأنها استبطان توجهات ومواقف تلقي بظلال من الشك على كل ما له علاقة إيجابية بالثورة، ولا تعرض القدر نفسه من التشكك حيال أطراف أخرى، مخاصمة ومعادية لها. « التوازن » كويس.
[ هل تعتقد أن هنالك طوائف مهيكلة واضحة المعالم في الحالة السورية، كما في لبنان والعراق مثلاً؟ بمعنى آخر هل نمتلك طوائف منجزة لها خطاب سياسي قادر على رسم حدود هذا الانقسام؟ وهل تعتقد أن تسوية طائفية مثل « الطائف اللبناني » ممكن أن تكون حلاً للحالة السورية؟
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=589960
—————————-
في شأن «جبهة النصرة» والسياسة الملائمة حيالها/ ياسين الحاج صالح
١٥ كانون الثاني ٢٠١٣
أثار التحفظ الذي عبر عنه قبل شهر ونيف كل من معاذ الخطيب، رئيس «الائتلاف الوطني السوري»، وجورج صبرا، رئيس المجلس الوطني السوري، على إدراج الولايات المتحدة «جبهة النصرة» في قائمة المنظمات الإرهابية امتعاضاً مسموع الصوت في أوساط مؤيدة للثورة السورية ومتعاطفة معها. تحيل المواقف المستاءة من كلام الرجلين إلى الصفة فوق الوطنية للمنظمة، وإلى طائفيتها المبدئية والنضالية، وما تجسده من «استنكاف عن القيم العالمية» على ما كتب الصديق حازم الأمين، ثم المجازفة بخسران أي مساعدة أميركية “فيما أحد المستفيدين من المساعدة طرف يمتّ بصلة حميمة إلى «القاعدة»”، في قول الصديق حازم صاغية. وفي خلاصة ذلك أن تحفظ الائتلاف الوطني يفتقر إلى الحس السياسي: «فأين السياسة والحال هذه في رفض الائتلاف قرار واشنطن؟» (حازم الأمين، الحياة 15\12\2012).
وفي سورية قيل ما يقارب ذلك، مع تركيز على الصفات التكفيرية والطائفية والإرهابية للمنظمة، أكثر من الإحالة إلى اعتبارات الحساسية والسياسة العالمية، التي لطالما اعتنى بها اللبنانيون أكثر من السوريين لأسباب تخص تكوين البلدين وفوارق الثقافة السياسية بينهما.
لكن أريد أن أدافع عن موقف «الائتلاف الوطني» استناداً إلى اعتبارات سياسية عملية، تبدو لي غائبة في مناقشة الأمر، ولا تبدو ظاهرة في موقف الائتلاف ذاته.
فمن شأن تسليم «الائتلاف الوطني»، بوصفه اليوم المظلة الأوسع للمعارضة السورية والمعترف بها دولياً، بالقرار الأميركي أن يعني استعداء المجموعة الإسلامية التي يقتصر «جهادها» اليوم على مواجهة النظام، وتالياً نقل العلاقة معها من حيز السياسة إلى حيز الحرب. وهذا ما لا تطيقه الثورة اليوم لكل أنواع الأسباب، وما لا يصح فيه التعويل على أن اعتبار الجبهة «منظمة إرهابية»، كما يريد الأميركيون، ولا يزالون الطرف العالمي الوحيد الذي يقول ذلك، لا يعني استعداءها والحرب عليها. إنه يعني. وهو بمثابة استيراد لمشكلة إلى داخل الثورة السورية، بينما هي بالكاد تتدبر مشكلتها الكبرى في مواجهة النظام. وفي ميادين المواجهة الحقيقية، حيث المجموعات المقاتلة تنشط قرب بعضها، هل ينتظر من مجموعات المقاومة المسلحة أن تقاطع “جبهة النصرة” فعلا التزاما بالأمر الأميركي؟ لن يفعل أحد ذلك بالقطع، وليس بتناول أحد مبرر وجيه لفعل ذلك اليوم.
وبالتالي فإن قبول أي سياسيين بهذا القرار يعزلهم بقدر ما عن المقاومة المسلحة ككل، ويضعف في المحصلة موقفهم السياسي.
لكن ليست هذه الاعتبارات السياسية العملية الراهنة وحدها ما تشكك في حكمة الانضمام إلى الموقف الأميركي من «جبهة النصرة». هناك ما هو أهم. فليس في سجل السياسة الأميركية من التعامل مع منظمة القاعدة، و«الحرب ضد الإرهاب» التي تجاوز عمرها 11 عاماً، ما يستند إليه كنهج مثمر يستحسن تقليده. لا يبدو أن أفغانستان، وهي «فترينة» عرض سياسة محاربة الإرهاب الأميركية، مثال إيجابي أو نصف إيجابي على جدوى هذه السياسة. ولا يبدو حال مقاطعات باكستان المجاورة لأفغانستان مثالاً يقتدي به، ولا أن اليمن مثال طيب. ربما لدى الأميركيين موانع نفسية تحول دون أن يقبلوا التفاوض مع منظمة ألحقت طعنة نجلاء بكبريائهم وهيبتهم العالمية، لكن حتى القوة العالمية الكبرى، وخصوصاً بعد أن شفت شيئاً من غليلها باغتيال أسامة بن لادن، يستحسن أن تصغي لصوت العقل، وتبدأ بالسياسة مع «القاعدة». من شأن ذلك أن يشجع الميول الأقل تطرفاً في الجماعة، ويطوي معركة لا يمكن النصر فيها بهذه الطريقة، بل إنها تعطي تشكيلاً شاذاً، كان يمكن أن يكون بلا مستقبل، أهمية تاريخية كبرى. «الحرب ضد الإرهاب» في حاجة إلى «الإرهاب» كي تدوم، ومن شأنها في سورية الجديدة أن تكون قاعدة تأهيل نظام أمني جديد وحالة طوارئ جديدة. هذا فوق أن هناك شريك واحد دائماً في «الحرب ضد الإرهاب»، هو الأميركيين، إلى درجة تبيح التساؤل عما إذا لم تكن الحرب ضد الإرهاب استراتيجية أميركية للشراكة في العمليات الأمنية العالمية ضد عدو للأميركيين، يراد تعميمه عالمياً أيضاً؟
وفي العموم، لا نرى غير واحدة من ثلاث سياسات ممكنة حيال «جبهة النصرة» وأشباهها في شروط الثورة، اليوم: (1) اعتبار الصراع مع النظام أساسياً ووجودياً، ومع النصرة ثانوياً، ويُعالج بالسياسة؛ (2) اعتبار الصراع مع النصرة أساسياً مثل الصراع مع النظام، وخوض صراعين في آن معا؛ (3) اعتبار الصراع مع النصرة هو الأساسي والوجودي، والصراع مع النظام ثانوي، ويعالج بالسياسة.
الخيار الأول هو ما يبدو متوافقا مع الثورة، وهو ما تسير وفقا له اليوم.
الخيار الثاني غير عقلاني من وجهة نظر الهدف المتمثل في إسقاط النظام، وهو بمثابة استدراج النفس إلى الهزيمة.
أما الخيار الثالث فهو بكل بساطة تخلٍّ عن هدف إسقاط النظام وإعلان لنهاية الثورة، وهو بالطبع المفضل من النظام والمعادين للثورة.
ليس هناك غير هذه الخيارات. وإذا كان الأخير مرفوضاً، والثاني غير عقلاني، لا يبقى غير الأول اليوم. حين تختلف الظروف، كأن يسقط النظام أو تنقلب النصرة إلى مواجهة مجموعات المقاومة المسلحة الأخرى، يتغير التقييم والموقف.
يفرض نفسه هنا اعتراض وجيه: لنفترض أننا رضينا بالسياسة مع «جبهة النصرة»، هل ترضى «جبهة النصرة» بالسياسة معنا؟ «الجهاد»، أي مزج الدين والحرب، ليس شيئاً تفعله “«جبهة النصرة»، بل هو شيء تكونه. إنها جهاد مستمر، إلى حين تفرض نموذجها. وطائفيتها مبدئية كما سبق القول، وليست أداة حكم مثل النظام الأسدي، أو أداة سياسية محتملة مثلما قد تكون عند قوى سياسية متنوعة.
هذه مشكلة كبرى بالفعل.
لكن هنا أيضاً تلتقي الاعتبارات العملية اليوم وبعد سقوط النظام (ضعف الموارد وضرورة تجنب صراعات إضافية) مع الاعتبارات المبدئية (أولوية السياسة في كل حال) على تزكية استنفاد سبل السياسة قبل أية مواجهة عنفية، هي «أبغض الحلال» في كل حال، وأبغض أبغض الحلال في بلد بالكاد يلملم أشلاءه بعد ثورة دامية.
وليس المقصود بالسياسة التفاوض وحده. هذا بُعد السياسة الإجرائي. المقصود مزيج من استيعاب وإعادة تأهيل من يمكن من مقاتلي الجبهة في الجيش أو في الحياة المدنية، والمقصود ما قد يلزم من «تأليف قلوب» البعض منهم، قادتهم الفكريين والسياسيين بخاصة، وهو مبدأ الاستيعاب السياسي الذي يحتاجه أي عهد جديد. والمقصود أيضاً ما قد يلزم من عمليات أمنية اضطرارية، تُظهر عزم الحكم الجديد على احتكار العنف في سورية الجديدة. وبما في هذه العمل على إبعاد أي مقاتلين غير سوريين. ما لا يمكن قبوله هو وجود تنظيم مسلح يخاصم الجهات العامة أو أية قطاعات من المجتمع. ولا ينبغي أن تكون هناك مشكلة إذا تحولت النصرة إلى تنظيم سلفي منزوع السلاح.
المقصود بعد هذا كله وضع عموم السوريين، مناصري «النصرة» ومخاصميها، في صورة جهود الحكم الجديد لمعالجة المشكلة وكسب أوسع قطاعات الرأي العام إلى جانب سياسته في هذا الشأن.
حتى إذا استنفِدت السبل السياسية في التعامل مع الجبهة دون جدوى، يكون أكثرية السوريين قد اقتنعوا بتعنت الجماعة وامتناعها عن الجنوح إلى السلم. وهذا بالغ الأهمية لأنه إذا كان لا بد في النهاية من مواجهة «جبهة النصرة» أو غيرها بالقوة، فينبغي أن تكون هذه المواجهة مؤثرة، تحقق تقدماً حاسماً في إضعاف منظمة معزولة، يُقِر الرأي العام السوري أنها عدوانية ومتطرفة، وتريد أن تفرض منطقها بالقوة على البلد وعموم السكان.
قول هذه الأشياء أسهل من فعلها للأسف. الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية تجعل كل شيء بالغ الصعوبة، لكن هذه الأوضاع ذاتها تسوغ بدرجة أقوى اجتناب مواجهة إضافية مع «جبهة النصرة» من شأنها أن تزيد الأوضاع الصعبة صعوبة واستعصاء على المعالجة. وقد يكون من شأن المواجهة أيضاً أن تتسبب بانتشار أوسع لبؤر الجبهة وغيرها من المجموعات الجهادية الإسلامية، بدل أن تكون خطوة إلى الأمام في ضبطها والتحكم بها.
سورية محتاجة في كل حال إلى إطلاق عملية مصالحة وطنية على مستويين رسمي وشعبي بعد سقوط النظام. ولا يعقل إطلاق هذه العملية بينما يجري خوض حرب ضد «منظمة إرهابية»، لم تكد ترهب أحدا حتى اليوم غير النظام، ولها متعاطفون لا يبدو أنهم قلة ضئيلة.
وفي هذا السياق من الكلام على السياسة العملية، من المهم منذ الآن أن يكون «للائتلاف الوطني» سياسة حيال النصرة تتجاوز مجرد الاعتراض على القرار الأميركي، أو اعتبار الجبهة مجرد جزء من المقاومة المسلحة مثل غيره. ليست كذلك، والجبهة لا تعتبر نفسها كذلك. ويلزم منذ الآن أن تبني قيادة «الائتلاف» قناة اتصال رسمية مع الجبهة، ومطالبتها بتوضيح رؤيتها وأهدافها، وأن تلتزم علانية بالعمل حصراً ضد النظام إلى حين التخلص منه. وكذلك التباحث حول اعترافها به كإطار للشرعية الوطنية بدل عن النظام. معلوم أن الجبهة رفضت الائتلاف وقت تشكيله، واعتبرته أداة للقوى الدولية التي تدعمه. وهذا نذير بصراعات مستقبلية مكلفة.
أما أن يدافع الائتلاف عن تشكيل ديني سياسي عسكري لا يعترف به، ولا يلتزم حياله بشيء، فهذا من سوء السياسة لا من حسنها. ووقت التفاوض على ذلك هو الآن، وليس «بعدين».
ختاماً، يقيد هذا التحليل نفسه بدائرة السياسة العملية في شروط الثورة اليوم. خارج هذه الدائرة، عند النظر في دوائر المجتمع أو الثقافة، تختلف المقاربة ومعايير الحكم والموقف.
موقع الجمهورية
—————————-
ما هي مشكلتنا مع «جبهة النصرة»؟/ ياسين الحاج صالح
٢٢ كانون الثاني ٢٠١٣
قبل كل شيء، خفض سقف التوقعات من الثورة.
بتنظيم جهادي يجمع بين كثير من الحرب وكثير من الدين لا يعد هذا النموذج السوريين إلا بحالة طوارئ مؤبدة جديدة وبمعارك وحروب وصراعات لا تنتهي. النظرة الإسلامية المعاصرة إلى العالم الحديث متشائمة، ترى فيه مكاناً شريراً وخطراً وفاسداً وخبيثاً ومتآمراً، وهو ما يؤسس لعلاقة عدائية، ولسياسة انعزال وتجنب المشابهة، وفي الداخل لقمع من يحتمل أن يوصفوا بالعلمانيين أو التغريبيين أو المنبهرين بالغرب.
في هذا جميع الإسلاميين شركاء، لكن التيار السلفي الجهادي الذي تنتسب له «جبهة النصرة لأهل الشام» يتفوق على غيره، ويحول هذه النظرة إلى العالم إلى سياسة مباشرة تقوم على المجابهة الدائمة. مشروع هذا التيار هو الحرب المستمرة، أو «الصراع المستمر» بهدف «ترويض الواقع»، على ما يقول عبدالله بن محمد في كتيب هاذٍ بعنوان «استراتيجية الحرب الإقليمية على أرض الشام». الحرب هنا، أو «الجهاد»، ليست وسيلة لغاية تتخطاها، بل يبدو أنه هو الغاية، ونظام «الخلافة» ذاته الذي هو الغاية المعلنة يبدو جهاداً مجسداً موصولاً.
ليس من أجل هذا تفجرت الثورة السورية.
إنها جهد قام به بشر عاديون أساساً، ودفع ثمنه بشر عاديون أساساً، ومن أجل عيش حياة عادية. لم تكن مشكلة السوريين مع النظام الأسدي أنه يمنعهم أن يكونوا أبطالاً أو مجاهدين جوالين، بل أنه لم يعد يتيح لأعداد متزايدة منهم العيش كأناس عاديين في ظله، بالحد المقبول من الكرامة المادية والسياسية. أظهر السوريون بطولات عظيمة أثناء الثورة، لكن أكثرها ليس في المجال الحربي، وكلها، المدنية منها والحربية، كانت اضطراراً فرض عليهم. كان بودّ الجميع كبشر أسوياء لو ينتهي هذا الصراع بأكلاف أدنى وفي وقت أقل، ولو أمكن تجنب الصراع المسلح، وما يتسبب به من تمزقات اجتماعية ووطنية نحن في غمارها اليوم.
ما كان لهذه التطلعات السوية أن تصمد في مواجهة نظام متوحش، ونعرف ملابسات ظهور وصعود المقاومة المسلحة، وصولاً إلى ظهور «جبهة النصرة» ذاتها قبل عام من اليوم. لكن هذا لا يجعل هذه التطورات شيئاً مرغوباً بحد ذاته، على ما يقول الكراس المشار إليه فوق، الذي يذكر ببعض الأدبيات الشيوعية حتى 3 أو 4 عقود مضت. كانت تلك الأدبيات ترى أنه كلما كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أسوأ في بلد ما كان هذا بيئة أنسب لتفجر الثورة، ولصعود نجم الثورين الحقيقيين. المشترك بين الحالين أن التدهور العام يغدو هدفاً مرغوباً، ولو مرحلياً، من أجل أن يعشش المجاهدون أو المناضلون في هذه البيئة، كخطوة على الدرب الطويل نحو الطوبى: الشيوعية في حالة، والخلافة الإسلامية في حالة.
لا نستطرد في نقطة الشبه هذه عرضاً، بل للقول إنه يحتمل لأناس مختلفي الجذور الإيديولوجية أن يسلكوا ويفكروا بطرق متقاربة في بعض الظروف التي قد تكون متقاربة. أي لإرجاع الأمر إلى الشروط الواقعية التي تظهر في ظلها مثل هذه المجموعات ومثل طرق التصرف هذه.
هذا التقارب البنيوي بين مجموعات إسلامية وشيوعية يفيدنا أيضا لتقدير المآلات المحتملة للنصرة وأشباهها، وتحديدا من حيث كونهما منتجتين لكثير من الطغيان واليأس.
ليس هناك أدنى احتمال في تقديرنا لأن يكون الأمر مختلفاً بخصوص الإسلاميين، وبدرجات متناسبة مع تشددهم الديني. كلما كانوا أكثر تشدداً، والنصرة من الأكثر تشدداً، كان الطغيان أشد واليأس أعمق. أفغانستان طالبان وتنظيم القاعدة لم يكونا مثالاً إيجابياً لأي شي في الدنيا من وجهة نظر إنسانية سوية. وتعليب الناس وفق نموذج واحد بحيث يكونون نسخاً متماثلة عما يفترض أنه المثال الصحيح العابر للعصور هو اليأس بعينه، والموت بعينه أيضاً. معقد الأمل هو تغير الحال نحو الأحسن، ولا مجال للأحسن في النموذج السلفي الجهادي لأنه الحسن ذاته والكمال ذاته. لكن هذا أنسب تعريف لليأس.
والحياة إنتاج مستمر للتنوع والمغايرة. والتشابه تعريف للموت.
وبقدر ما إن المثال الذي تتطلع إليها «النصرة» منفصل عن الواقع وممكناته، فإن الفجوة بين الواقعي والمثالي لن تجسر بغير الإرهاب، عنف لا حدود له بغرض «تهذيب وإعادة ترتيب أوضاع المنطقة» (الكتيب نفسه).
إلى ذلك يمكن للنموذج الذي تمثله «النصرة» أن يكون ركيزة لنظام قائم على امتيازات نخبة ضيقة، تسوغ امتيازاتها بالإسلام والشريعة وإرادة الله، لكنها لا تقل جشعاً واستهتاراً وقلة أخلاق عن أية نخب مماثلة، ومنها طغمة السلطة الأسدية اليوم. ليس هذا احتمالاً يمكن أن يقع أو لا يقع، بل إنه محتم إذا لم توازنه قوى أخرى أو يواجه بمقاومات اجتماعية مؤثرة. النظم العقدية التي تحتكر الصواب تؤول جميعاً إلى الطغيان السياسي، وإلى تكون نخبة صاحبة امتيازات خاصة، وإلى استخدام الدين من وراء قناع خدمته.
وتسهل عقيدة الولاء والبراء السلفية التي تجعل الدين، أو بالأحرى الحزب الديني، إطاراً للولاء، ومن هم خارجه أناسا يتعين التبرؤ منهم، تسهل أمر الطائفية ونشر الشقاق الاجتماعي، أو جعل الحرب مبدأ للعلاقات الاجتماعية داخل البلد. وفقاً لهذا النموذج سيكون إخوتنا من السلفين الجهاديين هم أهل الولاء ومستحقوه، مواطنو الدرجة الأولى، أو البعثيون الجدد. فيما الأغراب من عموم السوريين الآخرين هم رعايا أدنى مكانة، تتفاوت درجة اضطهادهم.
وبدل التخوين البعثي سيكون لدينا التكفير الإسلامي، وهما أداتان إيديولوجيتان لاحتكار السياسة والسلطة، أو تسويرها بالمبدأ الوطني السامي مرة، والمبدأ الديني المقدس مرة أخرى، بحيث لا يتجاسر عليها الخصوم، وبما يبيح للمتسلطين تجريم أي اعتراض عليهم، وربما إباحة دم الخصوم السياسيين.
وخلاصة القول أن النمط الفكري لـ«جبهة النصرة» لا يشكل قطيعة مع النمط البعثي، أو مع الطغيان كنظام سياسي، بل هو استمرار لهما على أسس إيديولوجية مختلفة، أكثر شباباً، وفي اتجاه أكثر تشدداً وتضييقاً.
* * * * *
لكن «جبهة النصرة» هذه التي تمثل خصماً من الثورة كقيم، كتطلع إلى سورية جديدة ديمقراطية، هي في الوقت نفسه سند للثورة كفاعلية مقاومة أو كصراع ضد النظام.
وبخصوصها تنضاف معضلة جديدة إلى نسيج المعضلات الكثيرة التي تواترت منذ بداية الثورة. فجبهة النصرة من المجموعات المقاتلة الأكثر انضباطاً وكفاءة، وهي صعدت باطراد مع تقدم الهدف السلبي للثورة، التخلص من النظام، على هدفها الإيجابي، سورية الجديدة الديمقراطية. علماً أن هذا التقدم حصل هذا بفعل تمادي النظام في العنف ضد بيئات الثورة وتصاعد أعداد الشهداء والدمار، أي مع ارتفاع الطلب على مقاومة النظام.
في هذا، الجبهة قوة فعالة منضبطة.
فإذا كان مدخلنا إلى الحكم عليها هو المدخل السياسي العملي الذي انطلقتُ منه في مقالة سابقة– بدت لنا الجبهة في ضوء أكثر إيجابية في شروطنا الحالية من مواجهة النظام الأسدي. أما إذا كان مدخلنا هو ما بعد النظام والاحتمالات الاجتماعية والسياسية والثقافية المكنونة في النموذج السلفي الجهادي كان محتما للحكم أن يكون سلبياً.
والمعضلة، تعريفاً، هي وضع يطرح علينا خيارين متناقضين، لا نستطيع الاكتفاء بأحدهما ضد الآخر، ولا الجمع بينهما. لا نستطيع أن نرحب بفاعلية «النصرة» القتالية ضد النظام، ونعمى عن تكوينها وتفكيرها؛ ولا أن نثبِّت أنظارنا على التكوين والتفكير، ونغفل عن دور «الجبهة» المهم في مقاومة نظام مستمر منذ عامين في قتل السوريين دون توقف. يركز بعضنا على أحد الوجهين دون الآخر، فيتعذر بناء سياسة عامة فعالة حيال هذه الظاهرة. في الوقت نفسه يتعذر بناء سياسة متماسكة تجمع بين تأييد النصرة قتالياً ونقدها فكرياً، وإن يكن هذا المسلك هو الأعدل ذاتياً في شروطنا الراهنة.
في مواجهة هذه المعضلة المتعذرة الحل اليوم يتراجع التماهي بالثورة أو تشيع المواقف الفاترة.
هذا المسلك الهروبي شائع في أوساط الطبقة الوسطى المتعلمة.
من جهتنا لا نرى أنه يمكن مواجهة «جبهة النصرة» بالهروب وإشاعة التشاؤم، ولا بالنقد الليبرالي، ولا بالوعظ الوطني والعلماني. يمكن مواجهتها، ويجب، بجبهة اجتماعية سياسية قوية، تتطلع إلى أوسع انخراط للسوريين في الحياة العامة لبلدهم. ملايين السوريين الناشطين سياسياً هم القوة الأمنع أمام مصادرة الثورة لأي طرف سياسي أو ديني.
وحده ما هو جيد في مواجهة نظام الطغيان هو الجيد لمواجهة «جبهة النصرة» وأشباهها.
موقع الجمهورية
————————————
=======================
المُحَلَّل في إهاب المُحَلِّل: توضيحات في شأن مقالة «حين الحال يُكذِّب المقال»/ ثائر ديب
في تاريخ 23 آب 2021، نشر موقع الجمهورية مقالةً بعنوان «حين الحال يُكذِّب المقال» لياسين الحاج صالح، كرّسها لنقد تناوليّ إيّاه في غير مكان. وهذه بعض التوضيحات أضعها، في هذا الشأن، بين أيدي القرّاء والمهتمين الذين قرأوا مقالة ياسين، مطالباً أن تُنشر في الموقع ذاته وبالشكل ذاته وعلى نحو يتيح ظهورها حيثما تظهر المقالة التي توضحها وتردّ عليها، كما تقتضي أصول النشر وأخلاقياته.
1- لطالما تغنّى أتباعٌ لياسين بأنّه مترفّع عن الردّ عليَّ وعلى سواي ممن يتناولونه. وهو يقول في مقالته إنّه تجنب الردّ على مرّاتِ شتمٍ وتسفيهٍ مارستُها حياله «لا تقل عن خمسين خلال عشر سنوات»، كي لا يشارك في «تسميم الجو العام»، وكي يترفّع عن «مجاراة سَبّاب رقيع».
حسنٌ، لا يورد ياسين في مقالته أيّ شتم أو تسفيه مما يشير إليه، وأتحدّاه أن يورد أيّ مقالة لي منشورة في موقع فيها أيّ شيء مما يزعمه. والأهمّ من ذلك بكثير إنني، وكثيرين ممن قرأوا المقالة، لا نصدّق زعم ياسين أنّه تجنّب الردّ للأسباب التي يذكرها. القصة وما فيها أنّ مقالةً لي عن اليسار السوري في العقد الماضي نُشرت مؤخّراً في موقع جدليّة أثارت حفيظة ياسين، وذلك بالضبط لأنّها ستكون متاحةً في ذلك الموقع لمعقلٍ لعلّه آخر معاقل ياسين ورهطه، أقصد الخارج، ولا سيما اليساريين والليبراليين والممولين الأجانب والعرب الذين هو بأمسّ الحاجة إليهم وإلى إبقائهم في جهل له ولاتجاهه وسياساته وتحالفاته، بعد أن كشف تطور الأمور تهافت تلك السياسات والتحالفات وأصحابها. ومن يتابع كتابات ياسين الأخيرة سيرى بيسر أنّها مكرَّسة لمهاجمة الإسلام السياسي التكفيري والطائفي الذي كان بجناحيه السياسي والمسلَّح حليف ياسين وأضرابه ومحلّ مديحهم ودفاعهم وصمتهم حتى البارحة.
2- في شأن القضية الأساسية التي تردّ عليها مقالة ياسين، أي ما يدعوه اتهامي له ولأشباهه بـ«تبرير الإرهاب التكفيري»، أقول إنَّ ما أتهمهم به لا يتوقّف في الحقيقة عند «التبرير»، بل يتعدّاه إلى «التحالف» مع الإرهاب التفكيري من موقع التابع الهزيل. ولن أقدّم دليلاً على هذا التحالف سوى تفنيد مقالته ذاتها لاتهامي، إذا ما استطاع القرّاء أن يخوضوا إلى النهاية ركاكة ذلك التفنيد وتهافته وإدانته لذاته وإثباته ما حاول أن ينفيه. أمّا الذين ينفرون من خوض غمار تلك الركاكة، فإليهم ما يقوله ياسين في 27 تشرين الثاني 2013:
«قبل عام كان زخم التحرير يبلغ ذروته في مناطق دمشق (الضواحي الجنوبية والغوطة الشرقية والغربية…)، ثم يتوقف بطريقة غير مفهومة لا تزال خباياها غير معروفة. اليوم كأنما يستعاد بعض هذا الزخم في شروط أصعب على كل المستويات. مقاتلو الغوطة يسترجعون اليوم العتيبة، وقبله مواقع عديدة فقدوها في الشهور الأخيرة. أهدرنا عاماً كاملاً، ما كان يجب إهداره بأية حال».
يوضح هذا القول إنَّ ياسين «شريك الدم» لمن يدعوهم مقاتلي الغوطة الذين لا يجهل أيّ سوري مَنْ هم ومن رأس حربتهم ومن الذي مولّهم وكيف كانوا وسلاحهم قارب نجاة النظام. غير أنّه، والحقّ يُقال «شريك دم مُضحك»، بتلك الـ«نا» الدالّة على الجماعة التي يستخدمها (أهدرنا… !) وفعل الأمر الذي يصدره كجنرال (ما كان يجب…!)، ليكتشف بعد رفّة جفن أنّ حلفاءه «في مناطق دمشق»، كما يدعوها، لا يتورعون عن تلقينه ما يُفترَض أن يكون أسوأ دروس حياته رغم خلافه «الثانوي» معهم والذي كان يُفترض أن «يُحَلّ بالسياسة»، كما قال عن خلافه مع «النصرة».
هكذا، لا يكون الخلاف بين ياسين الحاج صالح ومتزعّم «جيش الإسلام» زهران علوش في الأصل خلافاً بين نقيضين ولا حتى بين مختلفَين على المسائل الأساسية، بل خلاف بين حليفين، أو رفيقين في تحالف واحد. وما اضطرار ياسين وأمثاله ممن أدعوهم «يسار النصرة» اليوم إلى نقد هذا الضرب من الإسلام السياسي – بعد تكشّف الجريمة السياسية الكبرى التي ارتكبوها بتحالفهم معه، ومشاركتهم تالياً وبهذا المعنى في الجريمة الشخصية التي ارتكبت بحقّ النشطاء الأربعة في دوما وبينهم زوجة ياسين – سوى اضطرار لأن يتنصّلوا، ويمحوا ما لا يُمحى من آثار تحالفهم المشين والمجرم معه، الأمر الذي يفرضه، علاوة على التبرّؤ من إثم الجريمة، إرضاء الممولين الغربيين ورفاق اليسار الليبرالي الغربيين ممن لديهم نفاذ إلى خدمات كثيرة يمكن أن يوفّروها لياسين وأشباهه.
3- ينتمي ياسين لتيار سياسي وفكري أدعوه «مقبرة الأمل»، لطالما سارع برعونته وجهله إلى المساهمة (مع النظام وبعده) في اجتثاث كلّ بذرة أمل تبدأ بالتبرعم في سورية، ليعود بعد ذلك إلى التنصّل من أخطائه وجرائمه السياسية، كأنَّ شيئاً لم يكن. آخر التّحف على هذا الصعيد دروس جورج صبرا يوم 16 آب 2021 عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان:
«الدرس الأفغاني الجديد شديد البلاغة للذين بنوا وجودهم واستراتيجية عملهم على قوة الأجنبي على أرضهم وفي بلدهم، والعمل بظل إرادته. الدرس ليس جديداً بالطبع، فهو من الحقائق الوجودية للبشر والعلاقات. ومن يتلحف بعباءة الآخرين بردان مهما استطالت المدة، وراودته أوهام الدفء» .
كأنَّ جورج صبرا لم يطلب التدخّل الأميركي وسواه طوال العقد الماضي. وكأنه ليس من رأى أنّ دخول دبابات تركية إلى الأراضي السورية «خطوة إيجابية في محاربة الإرهاب والمشاريع التقسيمية على بلدنا سورية»….
قبله كان رياض الترك، بعد مغادرته سورية، وفي مقابلة في أوائل نيسان 2020 على بي بي سي العربية، قد أتحفنا، في معرض الكلام على أخطاء معارضته في التحالف مع الإخوان المسلمين، بالقول: «لم يلتزموا تماماً [يقصد الإخوان] بتوجّهات الثورة الديمقراطية الشعبية [كذا]» ولجأوا «إلى العنف». كأنَّ الأخوان من ملتزمي «الثورة الديمقراطية الشعبية» منذ نعومة أظفارهم، وكأنّ الترك لم يسمع قطّ رفيقه جورج صبرا، حين كان رئيساً للمجلس الوطني وهو يصرخ: «نريد سلاحاً» مكرراً ذلك ثلاث مرات.
يمكن سوق أمثلة من هذا النوع إلى ما لا نهاية، لكن الذي يهمّني هنا ليس ذلك، بل التقديم لتبياني تهافت اتهام ياسين لي بأنني «معارض للمعارضة والثورة». وهذه التهمة هي من نوع «الخزعبلات» التي يسهل تبديدها على أيّ طالب في المرحلة الابتدائية، ما إن يزيل «أل التعريف» من كلمتي «المعارضة» و«الثورة» في عبارة ياسين ويشكك في اعتباره أنّه وتياره هم «الـمعارضة والــثورة»، فتصبح العبارة «معارض لمعارضة وثورة»، أنا معارضٌ لهما بالفعل حتى آخر نفس، هما معارضة ياسين وأضرابه الذين سبقت الإشارة إليهم.
ليست معارضة ياسين سوى نوع بعينه من المعارضة أرسله الله هدية للنظام تنقذه كلّما تمأزق وتساهم معه في وأد بذور الأمل في مهدها. وليست ثورة ياسين سوى ثورة بعينها، هي في الحقيقة «ثورة مضادة» قادها (بعد انطلاقتها الشعبية العفوية في الشهرين الأولين) أردأ إسلام سياسي مسلّح وبعض مطياته وصنائعه المتلبرلين أصحاب السوابق «اليسارية» ممن يعانون «اضطراب الوجهة» و«اختلال الهوية». أمّا أنا فلي معارضتي وثورتي المغايرة. معارضتي هي المعارضة اليسارية الوطنية الديمقراطية التي غادرها وغدر بها تيّار ياسين، معارضتي هي معارضة عبد العزيز الخيّر وأحمد فايز الفواز ومحمود جديد وحسين العودات ويوسف عبدلكي وآلاف من أمثالهم. وبذلك يغدو اتهامي بأنني «معارض للمعارضة» نوعاً من الكذب الرخيص ليس غير.
4- ليس اتّهامي بـ«الصمت» عن النظام – بعد إجراء ما يلزم من فحص ثوري لدى «حكيم الثورة» الذي يتوهّم أنّه مؤهَّل لأن يطلق أحكامه علينا ويمنحنا هوياتنا – سوى محض افتراء مُغْثٍ كاتهامي بـ«معارضة المعارضة»، ذلك أنني بيّنت في كتابتي مئات المرّات أنَّ النظام علّة العلل وأنَّ بنيته التي حاولت أن أشرّحها مرّات جعلته جاهزاً لارتكاب أيّ شيء، وأنّ مشكلتنا مع المعارضة، لا سيما الياسينية منها، ليست أنّها سبب ما جرى بل أنها تتبّوأ مكان المعارضة من دون أن تكون منطويةً على حلّ. وبيّنت، تالياً، أنَّ الفشل في ما كان يلزم من النقض (أكثر من النقد) تجاه النظام لم يكن بسبب قمعه الوحشي وحده، بل بسبب نخبةٍ منها ياسين احتاجها شعبها فأخذته إلى مزيد من الكارثة. ولطالما اشتبهت في أنَّ «الردح» ضد النظام قد يخفي افتقاراً لفهمه ولحسم الموقف منه، وقد يخفي أخطاءً وجرائم لدى «الرادح» من نوع أخطاء النظام وجرائمه. ورأيت، تالياً، أنَّ نقد المعارضة الياسينية ضروري أشدّ الضرورة لأنها لا تزال تعتبر نفسها «الـ» معارضة، ولأنّ من الضروري وضع حدّ نظري وسياسي لـ«مقبرة الأمل» التي تمثّلها.
5- المُضحك، أخيراً، هو وضع ياسين لي على سرير التحليل النفسي ليمارس من الضرب تحت الحزام وتهويل التّهم ما لا يمارسه أي محلِّل عارف و/أو نزيه. فما يزعمه لدي من «معارضة المعارضة» و«الصمت حيال النظام» علّته، كما يفتري، أنني «جلّاد رمزي» سيجفّ قلمه ويصمت بزوال النظام. وهذا لا يستحق التفنيد بالطبع، بل يستحق الشفقة. لكنني أذكّر ياسين، بالمناسبة، أنَّ صمته المطبق عن عبد العزيز الخيّر، شأن صمته المطبق في كتابه بالخلاص يا شباب: 16 عاماً في السجون السورية، عن مازن شمسين، معتقل حزب العمل الشيوعي الذي كان يتلقى التعذيب عنه وعن سواه، شأن ضروب أخرى عديدة من الصمت ليس الآن أوان فضّها، لم يدفعنا إلى تحليله نفسياً ولا إلى اتهامه بمعارضة المعارضة، مع أنّ الأمرين ممكنان، بمقدار من الحقّ والسداد يفوقان بما لا يُقاس ما وجدنا لديه.
إن كنتُ جلّاداً رمزياً، وهذه لا يقولها سويّ، فنحن مع ياسين أمام شريك دم فعليّ لا رمزيّ، يدهشك مقدار ثقته العَرْطَل بنفسه، كما يدهشك مقدار أنانيته الشخصية وافتقاره إلى أدنى درجات نقد الذات نقداً جوهرياً، حتى بعد كلّ الذي جرى. وما أرجوه، رغم كلّ شيء، ألّا يكون السبب في هذين الأمرين ما قاله أحد الأصدقاء معلِّقاً على مقالة ياسين من أنّه كان لـ«يشنق نفسه» لو فعل.
موقع الجمهورية
=======================
————————————
تقارير كاذبة… حتى «آخر نفس»: رد/ ياسين الحاج صالح
بعد أن كنتُ مُبرِّرَاً لـ«الإرهاب التكفيري» في تقرير سابق له، يُظهِر ثائر ديب في تقرير أحدث أني «حليف» لذلك الإرهاب في الواقع، بل و«شريك دم». سأرد على هذه النقطة وغيرها هنا، وسأعتني بصورة خاصة بإيراد الوقائع والمعطيات ذات الصلة، وبالقدر الممكن من «الرواق» في هذا الشأن غير الرائق. ومثلما في الرد الأول، أخاطب قراء مجهولين، قد لا يحيطون بتفاصيل القضايا موضوع الجدال، ويرغبون في أن يعرفوا.
* * * * *
ليس تحالفي مع الإرهاب التكفيري عبارة عن واقع تقبل التحقق من مضمونها كي أرد عليها بعبارات عن واقع تقبل بدورها التحقق من مضمونها من نوع أني لم أقابل أحداً من «حلفائي» من الإرهابين التكفيريين يوماً، لا وقت كنت في الغوطة الشرقية لنحو 100 يوم ولا بعدها؛ أو أني نشرت ست بورتريهات لمقاتلين في الغوطة الشرقية في صيف 2013 ليس بينها واحدٌ لسلفي (البورتريهات هنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا)؛أو أني كتبت في دوما صورة، علمان، وراية في منتصف تموز 2013، المقالة التي ترى أن تقارباً بين سورية الثائرة و«الجمهورية العربية السورية» ممثلتين بعلميْهما الأخضر والأحمر هو ما يؤسس لطي صفحة شكلين متطرفين واستبعاديين لسورية، واحد تمثله صورة حافظ ثم بشار الأسد وواحد تمثله الرايات السلفية؛ أو، أخيراً، أني التزمتُ بدور الكاتب لا أتعداه إلى عالم التحالفات والشراكات.
على أن ديب يقدم، والحق يقال، «الدليل» الواقعي على تحالفي مع الإرهاب التكفيري. بمستوى أمانته المعهود، يورد سطوراً لا يبلغ قارئه أنها بوست لي على فيسبوك، أَحتفي فيها بكسر الحصار عن الغوطة الشرقية في 28 تشرين الثاني 2013، كبرهان على ذلك التحالف وتلك الشراكة. يقول البوست- الدليل التالي: «قبل عام كان زخم التحرير يبلغ ذروته في مناطق دمشق (الضواحي الجنوبية والغوطة الشرقية والغربية…)، ثم يتوقف بطريقة غير مفهومة لا تزال خباياها غير معروفة. اليوم كأنما يُستعاد بعض هذا الزخم في شروط أصعب على كل المستويات. مقاتلو الغوطة يسترجعون اليوم العتيبة، وقبله مواقع عديدة فقدوها في الشهور الأخيرة. أهدرنا عاماً كاملاً، ما كان يجب إهداره بأية حال». غير الاحتفاء، يتضمن هذا البوست شعوراً بالانتماء ووحدة الحال مع مقاتلي الغوطة الذين كانوا يدافعون عن أهلهم المحاصرين، والمعرضين للقصف الجوي والبري طوال عام. ولا يظهر ديب إلا جهله هو حين يقرر بصيغة مراوغة أنه «لا يجهل أيّ سوري مَنْ هم [مقاتلو الغوطة] ومن رأس حربتهم ومن الذي مولّهم». كان مقاتلو الغوطة في معظمهم ينتمون إلى الجذع الوطني الشعبي للثورة، بحسه المميز بالعدالة وبعفويته وتناقضاته، على ما يظهر من البورتريهات الستة المحال إليها للتو، وكلهم سوريون ومحليون. وكانوا يدافعون وقتها عن بيئات اجتماعية محاصرة تتعرض لقصف يومي، وقبل ثلاثة أشهر فقط من معركة العتيبة كانت بعض بلداتهم قد تعرضت لمذبحة كيماوية سقط فيها من 1466 من الأهالي، بينهم مئات الأطفال. هذا بالطبع لا يمكن أن يُذكَر في سجلّات ديب.
تحالفي مع «الإرهاب التكفيري» هو، بالتالي، شهوة اتهام وقتل معنوي من صنف ما برع الإعلام الأسدي به. ونصيبُ هذا الاتهام من الحقيقة لا يزيد في شيء عن نصيب كتائبي المسلحة أو إقامتي في السفارة الأميركية خلال عامين قضيتهما متخفياً في دمشق، وكان أشباهٌ لديب في الأخلاق والسياسة أثبتوهما بأدلة مثل أدلته منذ 2011.
نحن هنا حيال ممارسة كتابية تتهاون إلى أقصى حد في معايير قول الحقيقة، أي تشرِّع لنفسها الكذب، لأن هذا يناسبها. لقد اشتهى أن يقول إني حليف للإرهاب التكفيري، فهل يكفي اعتبارٌ شكليٌ من نوع أن هذا غير صحيح كي لا يقوله؟ لسنا حيال كلام يبتغي قول الحقيقة حتى يُدحَض بأنه بلا أساس من الواقع. نحن حيال كذب متعمد، يجري تكراره بلا توقف ليتحول إلى عقيدة راسخة.
وليس تحالفي مع الإرهاب التكفيري وحده غير الصحيح، بل كذلك ما يزعمه ديب من أن الإسلاميين، السياسيين منهم والمسلحين، كانوا «محلّ مديحهم [أنا و«أضرابي»] ودفاعهم وصمتهم حتى البارحة». فلم أمتدح الإسلاميين أو أدافع عنهم قط، ما دافعتُ عنه هو حقهم في العدالة والسياسة. قد يستعصي ذلك على فهم ديب، لكن إشكالية الاستيعاب التي انضبطت بها مقاربتي للإسلاميين من غير السلفيين والجهاديين لا علاقة لها بتقييم إيجابي لهم، فلا هي تقتضيه ولا تسمح به، وإن اقتضت تناولاً تفهُّمياً للظاهرة الإسلامية. نقطة انطلاق التصور الاستيعابي للنظام السياسي هي الاختلاف الأساسي والخصومة، وليس التوافق والمساندة، ثم الحاجة إلى قواعد لعب يتفق عليها المختلفون المتخاصمون من أجل قطع دورة العنف المتكررة. وفي بلد مثل بلدنا تسوده دولة مخصخصة ومُطيَّفَة، قتلت في جولة صراع أولى عشرات الألوف من محكوميها ومئات الألوف في جولة ثانية، لا يبدو هذا مجرد موضوع مهم من مواضيع السياسة، بل هو شرطها وتعريفها. ومهما أمكن لبناء نظام سياسي استيعابي، لا يستبعد الإسلاميين، أن يكون تحدياً عسيراً، فهو أدنى عسراً مما اقتضاه سلفاً تأبيد دولة التعذيب والكراهية الأسدية، أدنى كذلك مما أصاب سورية من تدمير على يد هذه الدولة وحُماتها الأجانب، الروس والإيرانيين وأتباعهم.
أدعُ جانباً هنا اجترار ديب لمفهوم «الإرهاب التكفيري» الذي تروجه الأجهزة الإيرانية والميليشيات التابعة لها، وهي قوى احتلال في سورية وضالعة في صنوف من إرهاب ديني بدوره ضد السوريين، كما ضد لبنانيين وعراقيين ويمنيين، وإيرانيين قبل الجميع. وهذا مع الدرجة صفر من الحس الإشكالي والعدد صفر من العناصر التحليلية بخصوص الإسلام السياسي والعسكري، مما يُنتظَر من كاتب معني بالنظر في شؤون بلده أن يقوم به، هذا إن لم يكن مُطبِّعاً لعنف الفاشية الأسدية. ليس تجريم كل مقاومة مسلحة للأسديين، بنسبتها إلى «الإرهاب التكفيري»، سوى الوجه الآخر لتطبيع عنف غير شرعي (تعذيبي، تمييزي، إرهابي، إبادي) لحكم غير شرعي.
* * * * *
ما أجد صعوبة خاصة في التعليق عليه هو استخدام تغييب زوجتي لتسجيل نقاط سياسية ضدي. يتحدث ديب في تقريره الثاني عن «الجريمة الشخصية التي ارتكبت بحقّ النشطاء الأربعة في دوما وبينهم زوجة ياسين»، ويرتب هذه الجريمة على تحالفي مع الإرهاب، الذي يرتفع هنا إلى شراكة دم، دم امرأتي. لا يفاجئني ديب مهما قال أو فعل، إلا أنني لا أجد بالفعل تعليقاً ممكناً على اختزال تغييب زوجتي إلى وظيفة البرهان على خطئي، وضمناً استحقاقي لما جرى لنا، وهذا ممن لم يُلمح إلى القضية قط إلا لغرض كهذا. هذه مقاربة توظيفية دنيئة لمأساة شخصية هي جزء من مأساة عامة هائلة، يتجاوز ضحاياها نصف مليون في أقل التقديرات، ويتجاوز ضحايا التغييب القسري مئة وثلاثين ألفاً. وهي بعد ذلك مأساة حمّلتُ نفسي قسطاً كبيراً من المسؤولية عنها طوال الوقت. أشك أن يوجد مثال آخر على هذه الدرجة من الخِسّة حيال قضية على هذه الدرجة من الإيلام.
وليس مفاجئاً في خطاب بهذا القدر من العنف والذكورية السامة أن تُعتبَر سميرة التي لا تستطيع الرد ضحية سلبية لسياستي الضالة، لا ولاية لها على نفسها ولا تقرر لنفسها، ولا انتماء لها إلى من عاشت بينهم وشاركتهم حياتهم، على ما هو ظاهر في كتابها يوميات الحصار في دوما 2013. وبطبيعة الحال لن يَرِدَ في أي من تقارير ديب أنَّ سميرة انضمت إليَّ في الغوطة الشرقية لأنها صارت مطلوبة للنظام بفضل كاتب تقرير يشبهه، شملني معها وشمل قريباً لنا اعتُقِل وعُذِّب، وأنه لم يكن في متناولنا خيار جيد للتعامل مع هذا الوضع المستجد. في واقع الأمر لم تكن لنا خيارات جيدة طوال الثورة ومنذ البداية، مثلنا في ذلك مثل سوريين كثيرين اختاروا موقعاً إلى جانب مواطنيهم الثائرين، وتقطعت بهم السبل.
* * * * *
ليس في كل هذه المعطيات ما هو جديد. ذكرتُ أكثرها غير مرة هنا وهناك. لكن في مثل شروطنا قد يكون ذكر الوقائع أهم من تجديد التحليلات، لأن الوقائع ذاتها ما تتعرض للنكران أو للتزييف. ثم لأن تغييب الوقائع أو تزييفها هو أحد أوجه صعود الشفاهة، بما في ذلك في الكتابة، وحلول مزاج سياسي قائم على الهوى والنميمة والإشاعة والتكرار، ومناسب بفعل ذلك لتنازع الهويات الأهلية، محل الموقف المكتوب والتحليل المكتوب والمعطيات الموثوقة.
في بنية الموقع الفكري والسياسي لخادم الشفاهة هذا، النظام ليس موجوداً كموضوع سياسي مستقل، يُنظَر فيه ويُكتَب بشأنه، ولا حتى الإسلاميون. كلاهما ذريعة لإعادة كتابة المقالة نفسها مئة مرة ضد الداعي وأمثاله. موضوع المعرفة، أياً يكن، غير موجود في عالم المكيود الأبدي. ما يوجد هو «آخر»، شخص أو مجموعة يكرر المكيود إشهار كراهيته لهم بلا نهاية، أو حتى «آخر نفس» على ما تعهد في تقريره الثاني بخصوص استمرار معارضته لي ولأمثالي. وليس هذا إلا لأننا، بحسبه، ننتحل دون وجه حق الموقع المعارض، ما يبدو أنه يحول بينه وبين إظهار كيف تكون المعارضة الحقيقية للنظام وحماته.
ربما في حياة أخرى، بعد آخر الأنفاس.
ولأن غياب قوله في النظام بنيوي وليس عارضاً، فإنه يمكن التنبؤ بما سيأتي كما لو أنه أتى وانتهى. فمثلما يسهل التنبؤ بسير آلة، يسهل أن نتنبأ بأنه لن يقول شيئاً عن أي جريمة كبيرة سيرتكبها النظام وحُماته (وسيرتكب النظام وحُماته الجرائم الكبيرة حتماً)، مثلما لم يسبق أن قال شيئاً. يمكن التنبؤ بيقين كذلك بأنه سيواصل التراقص حولي مثلما داوم على فعله طوال أكثر من عقد.
* * * * *
تبقى بضع نقاط تفصيلية، تتصل من جديد بوقائع تقبل التحقق منها.
يُحيل ديب في تقريره الثاني إلى كلام قاله رياض الترك وكلام آخر قاله جورج صبرا، وهذا مع علمه بأني لست عضواً في حزب الشعب الديمقراطي السوري، ولا حتى عضواً سابقاً على ما أورد في تقريره الأول. قلة الاستقامة ليست مما يستغرب منه، فما يلائمه يستخدمه، حتى لو كان عارفاً بأن ما يقوله غير صحيح. في ردي السابق كنت قد تناولت «أطروحة الصفر الاستعماري» المزعومة لرياض الترك من باب التمثيل على مزيج الاختلاق والتكرار الذي يطبع كتابة ديب، وليس تبنياً لما يقول الرجل.
في موقع من التقرير يذكر ديب شيئاً عن صمتي «المطبق» بخصوص عبد العزيز الخيّر. هذا أيضاً غير صحيح. ذكرت الخيّر مرات في سياق الكلام على التغييب القسري. هذه واقعة يمكن التحقق منها بيسر (وللتسهيل، هنا، وهنا، وهنا).
وقد يكون من لزوم ما لا يلزم القول إن من ينكر عليّ كاذباً عدم ذكر الخيِّر هو من لا يمكن أن يذكر رزان زيتونة ووائل حمادة وناظم حمادي، ومحمد عرب، وفائق المير، وجهاد أسعد محمد، وعلي مصطفى، وعلي الشهابي، وفراس الحاج صالح، وباولو دالوليو، واسماعيل الحامض، ولا يشير إلى سميرة نفسها إلّا في سياق النيل من زوجها. بل ليس ذكره للخيِّر نفسه تكريماً للغائب المحروم من الكلام، ولا إدانة لخاطفيه والتذكير بسجلهم في التغييب القسري لأزيد من مئة ألف من محكوميهم (وتغييب الجميع سياسياً، بمن فيهم الموالون)، وإنما هو يندرج ضمن المقاربة التوظيفية الرخيصة نفسها كمجرد أداة إضافية لاجترار سجلّ ضغائن سابق لتغيب الخيّر ولاحق له. مثل سميرة، عبد العزيز الخير لا يستطيع الرد، لكن قضيته تستحق أن يُذكِّر بها باستمرار على نحو يصونها كقضية حرية وعدالة، فلا تُترَك بيد موْتور يستخدمها في تسديد فواتير أحقاده.
يتكلم أيضاً على صمتي «المطبق» بدوره، في كتاب بالخلاص يا شباب، عن مازن شمسين (زميل سجن في عدرا وتدمر)، رغم أنه كان «يتلقى التعذيب» عني وعن سواي. أنا على يقين من أن مازن ليس مصدر معلومة ديب الكاذبة هي الأخرى. لقد عُذِّبت بالأصالة عن نفسي ولم يتلق أيٌ من رفاقي، لا مازن ولا غيره، تعذيباً بالوكالة عني في أي وقت. ثم أني لم ألتزم في الكتاب بذكر أسماء الرفاق والشركاء كلهم كي أغفل أسماء بعضهم لهوى في نفسي. وأعف هنا عن التعليق على استخدام النميمة في الكتابة، أياً يكن مدى صواب مضمونها. نحن حيال شخص لديه مشكلة مبدئية مع الأمانة.
مواصلاً مونولوجه المريض، يتوعد ديب بإفشاء «ضروب أخرى عديدة من الصمت [صمتي] ليس الآن أوان فضّها»، تُضاف إلى صمتي عن عبد العزيز الخير ومازن شمسين. انشغال كاتب التقريرين بكشف خفايا وفضح تحالفات و«فض ضروب من الصمت» يقربه كثيراً من المخبرين وكتبة التقارير السريين لأجهزة التعذيب الأسدية، يكشفون لها مثله أسراراً وخفايا، وإن لم يبلغوا مثله حد «فض الصمت». ديب موهوب أكثر في هذا الشأن، حتى أنه اكتشف أن السر وراء ردي عليه بعد طول تجاهل هو أني أخذت أحس بالخطر في «آخر معاقلي»، أي «الخارج»، من جراء كشفه عما خفي من حقيقتي لكل من «اليساريين والليبراليين والممولين الأجانب والعرب» ممن أنا «بأمسّ الحاجة إليهم وإلى إبقائهم في جهل» لاتجاهي وسياساتي وتحالفاتي. اكتشف كذلك أن «إرضاء الممولين الغربيين ورفاق اليسار الليبرالي الغربيين» هو سبب مكمل لتنصلي من الإسلاميين، يضاف إلى «التبرؤ من إثم الجريمة [جريمة تغييب زوجتي وأصدقائي]»، وهذا بعد تحالف وثيق تقدم ذكر الدليل الفيسبوكي عليه. انشغال بال ديب بأمر «الممولين» يرجح أن تتواتر تقاريره المخاطبة لهذه السلطة الجديدة.
ليس غير رقاعة في التكوين، أي انعدام جذري لاحترام النفس وللشرف في الخصومة، يمكن أن يوصل كاتب التقريرين إلى هذه المواصيل العُصابية. والطريف أنه يحتال على وصفي له بالسبّاب الرقيع بأن يتحدى أن أثبت وجود شتائم في مقالاته، فكأنما يوزع نفسه بين دكتور جيكل الفيسبوك الذي هو آية من آيات الرقاعة والإسفاف وبين مستر هايد المقالات الذي هو مسعور ومفعم بالكراهية فقط.
والخلاصة أنه حيث أورد ديب ادعاءات حول الواقع كانت كاذبة، وحيث أورد مرافعات اتهام كانت بلا سند من الواقع. يبقى الإخلاص في الكراهية حتى «آخر نفس» والرغبة العارمة في القتل المعنوي هما كل نصيبه من الحقيقة.
موقع الجمهورية
———————————
=======================




