سورية في أوروبا بحثاً عن الماء الساخن/ مروى ملحم
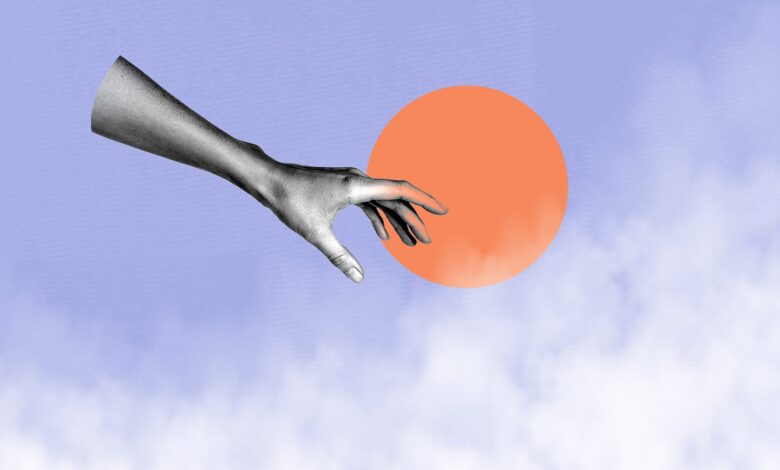
نشرت أول صورة لباريس ليلاً من شباك الطائرة، فكان أول رد من أحد الأصدقاء “كل هاد كهربا؟” وتتالت بعدها عبارات الوداع والسلام والأمنيات المذيلة جميعاً بتعليق مكرر عن الكهرباء “انعمي بالكهربا”، “جيبي معك شوية كهربا”، “انتبهي تتكهربي”، “كيف التقنين بفرنسا؟”
ربما كان عادياً في العام 50 قبل الميلاد أن تشعر نساء المملكة بالغيرة والحسد تجاه كليوباترا التي تستحم بالحليب لتحمي نقاء بشرتها ورونه، لكن المثير للعجب أن بعد ذلك بأكثر من ألفي عام، ينظر سكان “أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ” نساء ورجالاً وأطفالاً بحسد وحسرة تجاه سكان العالم جميعاً –ربما- ليس لأنهم يستحمون بالحليب أو بماء الورد، بل لأنهم يستحمون فقط بالماء الساخن!
ممرغة بأوحال الواقع السوري وحاملة إرهاصات يومياته بين تلافيف عقلي عميقاً عميقاً، سافرت إلى أوروبا منذ فترة قريبة، محققة حلماً كنت أثرثر عنه منذ أن كنت في الخامسة أو أقل، متلهفة لزيارة معالم باريس والتجول في شوارعها وإغراق صفحتي بالصور الملاصقة لكل شيء فيها. نشرت أول صورة لباريس ليلاً من شباك الطائرة، فكان أول رد من أحد الأصدقاء “كل هاد كهربا؟” وتتالت بعدها عبارات الوداع والسلام والأمنيات المذيلة جميعاً بتعليق مكرر عن الكهرباء “انعمي بالكهربا”، “جيبي معك شوية كهربا”، “انتبهي تتكهربي”، “كيف التقنين بفرنسا؟”.
هذا ليس جديداً، ويعرف الجميع أن وضع الكهرباء وجميع مصادر الطاقة في انحدار في سوريا منذ بداية الصراع، لكنه يبدو الآن مضخماً عشرات المرات، ويتحدث عنه السوريون أكثر بكثير، لسببين واضحين، الأول أنه أصبح بالفعل أسوأ بمراحل، بل أصبح هذا الشح جحيماً لا يطاق، خاصة في الشتاء، والسبب الثاني ورد في مقولة لمحمد المنسي قنديل أنه “أمام الموت تصبح كل الرغبات إثماً”. كان الحديث عن صعوبة العيش والتفاصيل المعقدة لتسخين الماء أو تدفئة البيوت يحتل المرتبة الثانية بعد تعداد الجثث والقذائف، والبعض كان يعتبرها أمراً ثانوياً لا يسع المرء التفكير فيه بينما شبح الموت الوشيك يحلق فوق رؤوسنا، لكن اليوم، حين انقشعت غيمة الرصاص قليلاً، نظر السوريون ملياً إلى حياتهم، الحياة التي لا تعدو أن تكون لهاثاُ مستمراً، ركضاً وراء نشرة الأسعار التي تبدو جزرة معلقة في رأس عصا ممدودة أمام حمار، مهما ركض لا يمكنه القبض عليها بأسنانه.
يقول يوسا: “لم يبدُ الوضع الراهن لي من قبل شنيعاً أكثر مما هو عليه، هذا ليس أسوأ مكان في العالم نعم، لكنني هنا وما أراه يوجعني”. كنت أفكر بهذه العبارة الصالحة لوصف سوريا في ذهني، أحدق في شجرات الميلاد المنصوبة والمضاءة بالكامل، بالأدخنة الخارجة من أسطح البنايات، بمحطات المترو المدفأة والتي لا يحتاج أحد أن يتدافع عليها أو أن يجلس على مقعد مكسور لأنه فوز عظيم إن تمكن من الحصول عليه في الزحام، سافرت بين بلدين وأنا لا أكف عن المقارنات، هنا لا أحد يسافر في الباص واقفاً مثل طلاب الجامعات في سوريا، لا أحد يشتري من الأزقة الخلفية قنينة بنزين أو إبريق مازوت من الحجم الصغير يكفي لتشغيل الحمام مرة واحدة، ولا أحد يفتش يائساً عن بطانيات المعونات التي أصبحت بثلاث طبقات، لأنها الحل الوحيد المتبقي.
لم يسألني أي من الأصدقاء عن معالم المدن التي كنت أتوق للحديث عنها، شعرت بالإحراج من الحديث عن الطابور الطويل أمام متحف اللوفر لأشخاص يقفون في طوابير للحصول على الخبز، عن الشوارع المضاءة منذ عصر التنوير في القرن التاسع عشر، عن الشانزلزيه ودور الأزياء ومعاطف الفرو وحقائب جلد التمساح، عن قوس النصر الذي يقع فوق محطة مترو تخدم قرابة تسعة ملايين مواطن يومياً. دخلت مقبرة بير لاشيز حيث السياح الأمريكيون واليابانيون لا يحتشد بريدهم مثلي برسائل من قبيل “لا ترجعي”، و”أخيراً هربتي”، “قدمي لجوء فوراً”، وأنا أترك برد باريس يتغلغل إلى أعماقي وأفكر في طلب اللجوء الذي سأقدمه وأقول فيه أنني “ألجأ إلى الدفء”. مشيت نحو قبر بلزاك التقطت صورة وأخبرته أن تلك التي “كان وجهها يشبه وجه شخص يمارس القسوة في السر”* هي سوريا، في السر والعلن.
في فترة تفكك الاتحاد السوفييتي، قيل إنه “لم يكن أحد يتحدث عن شراء شيء ما، لكن عن الحصول عليه، وأن نقص السلع الاستهلاكية كان له تأثير دائم على تفكير سكان البلاد حتى خلال مرحلة ما بعد الانهيار”، وفي سوريا حتى لو كنت تملك المال فمن الصعب جداً تأمين الاحتياجات المطلوبة، حتى لو حصلت على المازوت بسعر 50 ألف ليرة لكل 25 لتر، تشتريها من عائلة قررت بيع مخصصاتها، وحتى لو اشتريت البنزين الحر بسعر 4000 للتر الواحد، لكن من أين تأتي بالكهرباء؟ لم تعد البطاريات تفي بالغرض لأنها أصلاً لا تشحن، ولا المولدات يمكن توفير الفيول لها، وتكلفة تركيب الطاقة الشمسية آخر الصيحات تبدأ من 12 مليون ليرة للبيت الواحد، وفي نقاش هذه الفكرة مع صديق، أجاب بأن هذه الأزمات لا تدل حتماً على أن سوريا في طريقها إلى الانهيار، ما يزال هناك أمل، قد تحصل معجزة اقتصادية ما ليست أكثر من منحة تشبه المنحات الإيرانية أو الروسية أو التدفق الخليجي في السبعينات قد تنقذ الموقف، ولكن إن تحققت المعجزة على مستوى الدولة، المؤسسات، الاقتصاد، أياً يكن، ماذا عن الفرد؟ عن الأنا السورية التي تنازع في الداخل؟
لا يمكن إنكار أن الأنا السورية عانت دائماً من بعض التورمات والعنجهيات الفائضة، لطالما كان السوريون معتدّون بأنفسهم، لكن السنوات الأخيرة كان لها مفعول الحقن المهدئة، شيئاً فشيئاً يخفت كبرياء الفرد ويتضاءل، ثم يذوي مثل شمعة رخيصة. تتراجع إلى الخلف الانتماءات والخطابات ومن يصدق من، لأجل النجاة الفردية. لقد بدأت الخلطة الثقافية الحضارية التي عجنت هذا الكائن السوري عبر رحلة الزمان والمكان تتفكك، ودون تأصيل نظري، أعاد السوريون صياغة إيديولوجياتهم الفردية لتتقاطع في نقطة الخلاص، لا الغضب حتى، ولا الانتقام، بل حشر ما يمكن حشره من الوجدان المفتت في كيس مطاطي مقاوم للماء، والسباحة بعيداً.
في جلسة حوارية مع أساتذة المعهد الأورومتوسطي في اسبانيا، تكرر التطرق إلى قضايا السوريين، القوارب المطاطية، الاعتقالات، موت الأبناء، البيوت المهدمة، الآثار النفسية للحرب، اللاجئين وصعوبات الاندماج، الأطراف المقطعة، المساعدات الإنسانية، المنظمات، حماية الاطفال، دعم النساء، خيم المهجرين، سوريي الداخل المهتاجين مثل الدبابير المختنقة، الطنين حول المطارات، سوق الحقائب الذي يغلي، كيف أن الجميع يحاول الهرب أو تهريب أبنائه حتى لو كلف ذلك بيع المنزل أو أرض العائلة أو استدانة المال بالفائدة أو التسلل تحت جنح الليل عبر الخطوط الحدودية. أصبح السوري ملعوناً، ومع أنه ربما كما ذكرت إحدى الشابات السوريات “يشعر بأنه غير مرغوب به في أي من الدول”، إلا أنه ما إن يلحظ ثقباً في العش، يقفز مرتبكاً بذاكرته المشوشة، وأنا أيضاً هربت، لكنني عشت في الشوارع الأوروبية حالة انفصام حاد، أسى غير واضح، أجبت عند سؤالي عن الأحوال في سوريا بأنه “من الصعب حقاً أن تكون رب أسرة في سوريا الآن”، ولكن هناك بقية، من الصعب ان تكون جامعياً، أو طبيباً، أو مريضاً، أو ابناً، أو ناشطاً مجتمعياً، أو بائعاً، أو مدرساً للتاريخ، أو باحثاً سياسياً، أو منظراً، أو…. إنك تحلم بالفرار لكنك حين تفر لا تعرف ماذا ستفعل، هل تمضي عمرك بقراءة منشورات الفيسبوك عن أصدقائك الذين انتظروا سخان الحمام ثلاثة أيام حتى تجمع فيه بعض الماء الساخن؟ هل تندد بالظلم وتحرّضهم على الثورة؟ هل تنقب في معالم عصر النهضة وتتابع الفنانين والمثقفين بحثاً عن دافينشي ودانتي ومايكل أنجلو سوريين؟ أم تعود أدراجك لتفكر مجدداً بمعنى الانتماء والهوية؟
في فيلم المخرج اليوناني أنجيلوبولوس “خطوة اللقلق المترددة”، وعنوانه يبدو وصفاُ دقيقاً لحالتي، تقول الشابة “العروس” التي عبرت النهر إلى حبيبها “لقد عبرنا الحدود لكننا ما نزال هناك، كم على المرء أن يعبر حدوداً… كي يكون في بيته؟!”.
درج




