مجزرة التضامن المروعة، الفيديو كاملا، ترجمة كاملة للتحقيق من عدة مصادر، تحليلات ومقالات تناولت المجزرة

———————
الفيديو كاملا
———————
فيديو مجزرة التضامن المروعة.. كيف لاحق باحثان أحد مجرمي الحرب في سوريا؟
الغارديان – ترجمة: ربى خدام الجامع
قبل ثلاث سنوات وفي صبيحة يوم ربيعي، وصل إلى يد مجند جديد لدى ميليشيا موالية في سوريا جهاز حاسوب محمول يعود لأحد أذرع بشار الأسد الأمنية وهو شخص يهابه الناس جميعاً، وطلب منه أن يصلح ذلك الحاسوب، وعندما فتح الشاشة، دفعه فضوله للنقر على ملف لفيديو، في حركة جريئة جداً بسبب العواقب التي يمكن أن يتعرض لها في حال ضبطه أحدهم وهو يتجسس.
كان مقطع الفيديو متقطعاً في بدايته، وذلك قبل أن يتم التركيز فيه وتقريب الصورة على حفرة حفرت حديثاً في الأرض بين مبنيين اخترقتهما كثير من طلقات الرصاص. رأى ذلك الشاب بعد ذلك أحد ضباط المخابرات الذين يعرفهم وهو يركع بالقرب من حافة الحفرة مرتدياً زيه العسكري ومعتمراً قبعة صيد، وهو يلوح مهدداً ببندقيته ويصدر أوامره بصوت مبحوح.
الجريمة.. في مقطع فيديو
جمد الدم خوفاً في عروق ذلك المجند الغر وهو يتابع ما جرى، إذ ظهر رجل معصوب العينين اقتيد من ذراعه إلى المكان، ثم طلب منه أن يهرول باتجاه الحفرة الضخمة من دون أن يدري أنها كانت أمامه، كما لم يتوقع أن يسمع وابل الرصاص الذي اخترق جسده الذي أخذ يتهاوى فوق كومة من القتلى تحته. ثم تبعه معتقلون آخرون، واحداً تلو الآخر، من دون أن يساورهم أدنى شك بما يمكن أن يحدث لهم، إذ قيل لبعض منهم إنهم سيجرون بعيداً عن قناص موجود في الجوار، في حين تعرض الآخرون للسخرية والإهانة في آخر لحظات حياتهم، إلا أن معظمهم كانوا يظنون بأن من قتلوهم كانوا يقودونهم إلى بر الأمان.
وبعد انتهاء عملية القتل، كان هناك ما لا يقل عن 41 رجلاً قد قتلوا داخل القبر الجماعي الموجود في حي التضامن بدمشق، والذي تحول حينئذ إلى جبهة قتال خلال فترة النزاع بين رأس النظام في سوريا والثوار الذين قاموا عليه. وإلى جانب أكوام التراب التي استخدمت لإتمام العمل على عجل، قام القتلة بسكب الوقود على ما تبقى من الضحايا وإضرام النار فيهم، وهم يتضاحكون في أثناء تسترهم بشكل حرفي على جريمة حرب وقعت على بعد بضعة كيلومترات من مقر الرئاسة في سوريا، أما التاريخ الظاهر على ذلك الفيديو فيعود لـ16 نيسان 2013.
أحس ذلك المجند الجديد بحالة غثيان منعته من الحركة، لكنه قرر على الفور أنه لا بد من عرض هذا المقطع في مكان آخر، وهذا القرار هو الذي دفعه، بعد مرور ثلاث سنوات على ذلك، لخوض رحلة خطرة نقلته من أحلك اللحظات في تاريخ سوريا الحديث إلى حالة الأمان النسبية في أوروبا، حيث التقى هناك بشخصيتين أكاديميتين أمضتا سنوات وهما تحاولان الوصول إليه وتأمينه، بما أنه يعتبر المصدر الرئيس في تحقيق استثنائي، إلى جانب سعيهما للتعرف إلى هوية الشخص الذي أدار تلك المجزرة وإقناعه بالاعتراف بالدور الذي لعبه.
إنها قصة جريمة حرب تم تصويرها لحظة ارتكابها على يد أحد المتنفذين لدى النظام السوري المعروفين بسوء صيتهم، من الفرع 227 لدى المخابرات العسكرية، وهذا بحد ذاته يعبر بشكل جلي ومفصل عن الجهود المضنية الساعية لقلب الطاولة على هؤلاء المجرمين، إذ شملت تلك الجهود ما قام به باحثان في أمستردام وما مارساه من تضليل وخداع مع أسوأ ضباط الأمن صيتاً في سوريا، وذلك عبر إرضاء غروره من خلال الإنترنت، واستمالته حتى يقوم بنشر أسرار الحرب التي شنها الأسد.
لقد سلط العمل الذي قام به هذان الباحثان الضوء بشكل غير مسبوق على جرائم يعتقد أن النظام ارتكبها على نطاق واسع مع وصول الحرب السورية إلى ذروتها، لكنه أنكرها أو نسبها إلى فصائل الثوار والمجاهدين.
فن التخويف
بعد مرور تسع سنوات على ذلك، ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، عمدت القوات الروسية إلى إعادة تفعيل العمل بالدليل الخاص بإرهاب الدولة بحق المدنيين والذي سبق لها أن تدربت عليه في سوريا، وذلك بعد تحول ما وصفه فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية الخاصة إلى احتلال جائر لأجزاء من شرقي أوكرانيا. فقد أتت وحدات الاستخبارات العسكرية الروسية لتكون في المقدمة خلال العمليات الوحشية القائمة على بث الذعر في نفوس الناس عبر الاعتقالات والقتل الجماعي على غرار محاولات الأسد الوحشية الساعية للتمسك بالسلطة في البلاد.
بما أن أجهزة الأمن في سوريا قد تدربت على يد الضباط السوفييت وضباط أمن الدولة الروس في ستينيات القرن الماضي، لذا فقد اطلعوا بشكل جيد على فن التخويف، إذ إن ولاء من يتم اعتقالهم عند الحواجز ونقاط التفتيش لا تترتب عليه عواقب جسيمة في معظم الأحيان، لأن الخوف كان وسيلة النظام الأنجع للتمسك بالسلطة، ولهذا لم يعدم وسيلة حتى يزرع الخوف في النفوس. وفي هذه الحالة، لم يكن الضحايا من الثوار، بل كانوا مدنيين لم ينحازوا إلى أي طرف، وارتضوا لأنفسهم أن يبقوا بحماية الأسد. إلا أن غالبية أهالي التضامن رأت في قتلهم رسالة لكل سكان ذلك الحي وهي: “لا تفكروا حتى بمعارضتنا”.
بعد تسريب ذلك الفيديو، لأحد ناشطي المعارضة في فرنسا أولاً، ثم لهذين الباحثين وهما أنصار شحود والبروفسور أوغور أوميت أونغور، من مركز المحرقة والإبادة الجماعية التابع لجامعة أمستردام، بات على المصدر أن يتغلب على خوفه من الاعتقال والقتل واحتمال نبذ أسرته له، بما أنها تنتمي إلى الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، وهنالك كثير من أقاربه يشغلون مناصب كبرى في السلطة ضمن ما تبقى من سوريا. بيد أنه أدرك في نهاية الأمر بأنه مع وجود مئات الأشخاص في مختلف بقاع العالم يسعون لمحاكمة الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها، سيصبح هذا الفيديو دليلاً بارزاً في القضية التي سترفع على بشار الأسد.
ولكن في بداية الأمر، كان على أنصار وأوغور التعرف إلى هوية الشخص الذي يعتمر قبعة صيد، ولذلك لجآ إلى الشيء الوحيد الذي اعتقدا أن بوسعه مساعدتهما في تحقيق ذلك، ألا وهو صديق صدوق.
Anna Sh على فيس بوك
كانت أنصار ممن انتقدوا الأسد بصوت عال منذ اندلاع الحرب السورية، بالرغم من أن عائلتها تنتمي إلى طائفة احتفظت بعلاقات طيبة مع الأسد، إلا أن النزاع وما تبعه من انهيار اقتصادي جعل التوتر يسود تلك التحالفات، فلم تجد أنصار نفسها إلا وقد قررت محاسبة الأسد، بصرف النظر عن الثمن الذي ستدفعه هي على المستوى الشخصي.
ولذلك انتقلت إلى بيروت في عام 2013 وبعدها بسنتين إلى أمستردام، وهناك التقت بأوغور في عام 2016، إذ كان لدى كل منهما دافع قوي لتوثيق ما يعتبرانه مجزرة ترتكب في سوريا، ومن الطرق التي اتبعاها لتحقيق ذلك جمع قصص الناجين وعائلاتهم وترتيبها، والتحدث إلى المجرمين أنفسهم، إلا أن خرق القانون الخاص للنظام السوري كان أشبه بمهمة مستحيلة، لكن أنصار وضعت خطة للقيام بذلك، وذلك عندما قررت اللجوء إلى الإنترنت، لتصل إلى الدائرة المغلقة التي تضم ضباط الأمن لدى النظام، حيث أخذت تدعي بأنها معجبة بهم، وتؤمن بقضيتهم بشكل كامل.
من غرفة الصالون الخشبية الداكنة والفخمة في مركز المحرقة والإبادة الجماعية، يحدثنا أوغور عن ذلك فيقول: “كانت المشكلة تتمثل في صعوبة دراسة نظام الأسد، إذ ليس بوسعك أن تسافر إلى دمشق لتلوح بذارعيك هناك وأنت تقول: مرحباً، أنا عالم اجتماع من أمستردام وأود أن أطرح بعض الأسئلة.. ولهذا توصلنا إلى نتيجة مفادها بأننا بحاجة إلى شخصية وهذه الشخصية يجب أن تكون لامرأة علوية شابة”.
كانت أنصار تعرف بأن جواسيس النظام والضباط العسكريين لديه يميلون لاستخدام فيس بوك، إذ بالرغم من سرية حياتهم المهنية، فإنهم لا يجعلون من بيئة التواصل الاجتماعي لديهم بيئة خاصة أو شخصية، ولهذا اختارت لنفسها اسماً وهمياً وهو: Anna Sh، وطلبت من صديق مصور أن يلتقط لها صورة مغرية تظهر جانباً من وجهها، بعد ذلك نشرت على الصفحة الرئيسية تحية كبيرة لبشار الأسد ولعائلته، وانطلقت في محاولتها لتجنيد الأصدقاء.
بقيت أنصار تجوب فيس بوك ليل نهار على مدار العامين التاليين وهي تحاول البحث عن أي شخصية مشتبه بها، وعندما وجدت من صدقها، أخبرته بأنها باحثة تدرس النظام السوري من أجل أطروحتها، وقد نجحت في ذلك في نهاية المطاف، إذ تعرفت إلى مزاج النظام حينئذ، فصاغت برفقة أوغور نكاتاً ونقاطاً للحديث لتساعدها في الوصول إلى نهج معين. وسرعان ما أصبحت Anna Sh معروفة بين أوساط الأمن في سوريا بأنها شخصية متفهمة، ومتعاطفة أيضاً، وعن ذلك تحدثنا أنصار فتقول: “كانوا بحاجة للتحدث إلى أي شخص كان، ليحكوا له عن تجاربهم، ولهذا أطلعناهم على بعض القصص والأخبار، واستمعنا لكل الأخبار التي حدثونا عنها، من دون أن نركز على جرائمهم وحسب”.
ويتابع أوغور فيقول: “لقد تعلق بعض منهم بآنا، وصار بعضهم يتصل بها في منتصف الليل”.
وهكذا، وعلى مدار العامين التاليين، أصبحت أنصار تعيش وتتنفس بوصفها شخصية أخرى، بيد أنها كانت في بعض الأحيان تتخلى عن تلك الشخصية الجديدة، بعدما تعرفت إلى عقول ضحاياها، وصار بوسعها فهمهم على المستوى الإنساني البحت الذي يتجاوز حدود البحث الذي تجريه.
إلا أن تلك العودة إلى الواقع كانت تأتي بشكل مفاجئ عادة، وذلك لأن غالبية من كانت تتحدث إليهم كانوا أعضاء نشطين في آلة القتل، في حين كان بعضهم الآخر يمثل فئة مستعدة للقتل ضمن تلك العصابة التي انضموا إليها. وقد أثر ذلك على صحتها بصورة سلبية، كما أثر على حياتها الاجتماعية وحالتها العقلية والنفسية، إلا أن الجائزة كانت تستحق كل هذا العناء، إذ إن تمكنت من العثور على المسلح الظاهر في الفيديو، فعندئذ سيكون بوسعها إنصاف عائلات الأشخاص الذين قتلوا على يده، وقد يصبح بمقدورها البدء بما نجحت به قلة قليلة طوال عقد من النزاع، أي البدء بعملية تربط بشكل غير قابل للدحض أو التكذيب الدولة السورية ببعض من أسوأ الجرائم التي ترتكب خلال الحرب.
في آذار 2021، حصل التقدم في ذلك السياق أخيراً، بعدما كسب حساب Anna Sh على فيس بوك ثقة أكثر من 500 مسؤول مخلص لدى النظام. وبينما كانت تبحث في صور الأصدقاء الذين أوقعت بهم بحبائلها هناك، ظهرت لها صورة لرجل صاحب وجه دائري مميز ظهرت عليه ندبة وله لحية، كان هذا الشاب قد أطلق على نفسه اسم أمجد يوسف، وكان هذا الشخص يشبه إلى حد كبير الرجل المسلح الذين كان يعتمر قبعة صيد والذي أنهكت أنصار نفسها وهي تبحث عنه. وبعد فترة قصيرة، حصلت أنصار، أو Anna Sh -إذ كان من الصعب التمييز بينهما حينئذ- على دليل قدمه مصدر من داخل التضامن يؤكد أن القاتل يحمل رتبة رائد في الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية في سوريا، وعن ذلك تقول: “شعرت بارتياح لا يوصف، إذ كان أمامي شخص لديه مفتاح كل شيء، لذا كان علي أن أدفعه للحديث معي”.
تتذكر أنصار تلك اللحظة التي ضغطت فيها على زر إرسال طلب الصداقة، والحماسة التي غمرتها عند قبول الضحية للطلب، أي أنه ابتلع الطعم بعد مرور كل هذا الوقت. والآن يجب عليها أن تستميله، إلا أن المكالمة الأولى أتت عابرة وسريعة، وذلك لأن أمجد شك بها فأنهى المكالمة سريعاً، إلا أن شيئاً ما في تلك المحادثة الأولى ألهب فضوله، فتحول الصياد إلى فريسة، ولكن هل كان ذلك بسبب الإثارة التي يشعر بها المرء عندما يتحدث إلى امرأة غريبة؟ أم أنه كان بحاجة إلى استجواب الشخص الذي تجرأ على الاقتراب منه؟ أم أن السبب شيء آخر؟ على أية حال، عندما اتصل أمجد اتصال فيديو بعد مرور ثلاثة أشهر على ذلك، ضغطت أنصار على زر التسجيل، وهي ترد على المكالمة باسم آنا.
التعرف إلى القاتل كإنسان
بعد مرور كل تلك السنين، وقع ذلك المجرم في الفخ، بالرغم من أنه كان صارماً في البداية، فطبيعة شخصيته تعود لجاسوس يسيطر على كل حواراته ويستعين بصمت القبور على الفور كسلاح يدافع به عن نفسه، ولهذا كان حديثه مقتضباً، وإذا تحدث يأتي حديثه تمتمة، بشكل يجبر السامع على الإنصات له بثبات. إلا أن آنا فعلت كل ما بوسعها لتجرد أمجد من أسلحته، حيث أخذت تبتسم له بخجل وتضحك وهي تخضع له مذعنة وهو يمطرها بالأسئلة، وهكذا جرى كل شيء وفقاً لشروطه، وبالتدريج بدأ وجهه الجامد يسترخي، فكسبت آنا الجولة، وهنا سألته عن التضامن، ثم طرحت عليه سؤالاً غير نبرة المحادثة كلها، وهو: “كيف كان شعورك وأنت جائع ومحروم من النوم، وأنت تحارب وتقتل وخائف على أهلك، وعلى شعبك. إنها مسؤولية كبيرة، وقد حملتها على كتفيك”.
عندئذ اعتدل أمجد على كرسيه، في إقرار منه بظهور شخص يتفهم العبء الذي يتحمله أخيراً. ومنذ تلك اللحظة، أصبح هو الذي يشغل مقعد الاستجواب، أي أن الحوار لم يعد بيده، وذلك لأن آنا كانت لديها إجابة عن كل رد من ردوده، وهذا ما عزز ثقته وبث الطمأنينة لديه، وأرضى غروره. وهكذا تحولت آنا إلى معالجة نفسية لديه، وصوت لأفكاره، وامرأة موضع ثقة بما أنها أصبحت تفهمه من دون أن تطلق أحكاماً عليه.
تعلق أنصار على ذلك بقولها: “لا أنكر بأنني كنت أحس بحماسة غامرة وأنا أتحدث إليه، ولهذا كنت أبتسم، لأنني كنت سعيدة بالحديث إليه، ولكن حتى نعرف قصصهم وأخبارهم، علينا أن نقنعهم بأننا باحثون وحسب، وعندها سيفتحون قلوبهم، وهذا لم يأت عبر مقابلة واحدة، بل بعد التخفي لمدة أربع سنوات. تعلمت خلالها بشكل تدريجي كيف أفصل نفسي عن تلك الشخصية، حيث خلقت هذه الفتاة المعجبة بما يفعلونه بالفعل، وهذا قاس علي، إذ كنت عندما أغلق الحاسوب المحمول أحس بأني قمت بمهمة شديدة الوطأة، ولكنها ضرورية، إلا أني كنت أرغب بالتعرف إليه كإنسان”.
خلال صيف العام الفائت، حاولت أنصار بمساعدة تلك الشخصية الوهمية، وبمساعدة أوغور الذي كان يجلس بعيداً عن الشاشة في معظم الأحيان، إقناع أمجد بالحديث، فقد كان هدفهم الولوج إلى عقل القاتل، إلا أن هدفهم الآخر هو جمع معلومات حقيقية حول السبب الذي دفعه للقيام بذلك وانتزاع اعترافات منه. ولهذا أخذا يبحثان في حسابه على فيس بوك حتى يعثرا عن أي مفتاح يقودهم لذلك، فصادف أن عثرا على صورة لشقيقه الأصغر، وقصائد كتبها أمجد عقب وفاة شقيقه هذا في مطلع عام 2013، أي قبل ثلاثة أشهر من وقوع مجزرة التضامن. بقيت آنا تلاحقه من أجل مكالمة أخرى، لكنه ظل يتملص منها، ولكن في ساعة متأخرة من إحدى ليالي حزيران، أضاءت شاشة هاتفها معلنة عن اتصال عبر فيس بوك ماسنجر، كان أمجد هو المتصل، وكانت تلك فرصتها لكسب وده.
“قتلت الكثير”
كان أمجد مرتاحاً بشكل أكبر هذه المرة، فقد كان يرتدي قميصاً داخلياً وقد وضع علبة مشروب أو اثنتين على الطاولة. كانت الساحة له يومئذ، أو هكذا اعتقد، ولهذا بدأ بحديث مقتضب، حاول من خلاله أن يطرح أسئلة غير مباشرة على آنا التي انتهزت الفرصة وسألته عن شقيقه، وعندئذ بدأ القاتل والمتنفذ الذي يهابه الجميع بالبكاء، عندئذ تحولت آنا إلى وضع المعالجة النفسية، فأخذ يخبرها بأن عليه أن يبقى في الجيش بالرغم من احتمال أن تفجع والدته بفقدان ابن آخر، وأضاف قائلاً: “لقد فعلت ما يجب علي فعله”، بعد ذلك أتى أول اعتراف من قبل أمجد عندما قال: “لقد قتلت الكثير، وأخذت بثأري”.
واعترافاً منه بخطورة ما قاله، قطع أمجد الحديث وأنهى الاتصال، وبات من الصعب العثور عليه طوال الأشهر القليلة التي أتت عقب تلك المحادثة، إذ لم يكن يرد إلا كتابة وأخذ يسأل آنا عن موعد عودتها إلى سوريا، فمن هي تلك المرأة التي سلبته لبه؟ ومتى سيتسنى له استجوابها على طريقته وبشروطه؟
بدأ أمجد بلعب دور الحبيب الغيور، وذلك عندما سأل آنا عن علاقاتها السابقة، وإن كانت تشرب أم لا، وعن الأماكن التي عاشت فيها.
في تلك الأثناء، أصبحت آنا تحس بأن الجانب الآخر من شخصيتها قد بلغ أقصى حدود إمكانياتها، وبأن Anna Sh أضحت بحاجة إلى قسط من الراحة، وهذا ما فعلته، وذلك لأن تلك الشخصية تحدثت إلى نحو 200 مسؤول لدى النظام، بعضهم شارك بطريقة مباشرة في عمليات القتل، وبعضهم ينتمي إلى طائفة ساعدت الأسد وحرضته على محاولاته الوحشية للتمسك بالسلطة. ولذلك بدأت تلك الشخصيات تتساءل عن سر تلك المرأة الموجودة في صندوق الوارد لدى كل منهم.
اغتيال آنا
أواخر العام الماضي، بعدما تحدثت أنصار إلى امرأة اتهمت أمجد بالاعتداء عليها، شعرت بأنها اكتفت من كل ذلك، وذلك لأن كل ذلك التعاطف الذي أبدته تجاه القتلة بدأ يتسرب إلى أعماق روحها، وكذلك الأمر بالنسبة لتقمصها لتلك الشخصية، وعن ذلك تخبرنا فتقول: “أنصار تستحق العيش أيضاً، ومن هنا أتى السؤال: أين أنصار؟ ومن هي أنصار الآن؟ هل ضاعت في البحث؟ فقد استطاعت آنا أن تدعي أنها موجودة بالفعل وأن تتظاهر بأنها علوية حقاً، حيث بقيت تمثل ذلك الدور لساعات هنا في أمستردام. ولكني أعتقد بأن آنا تجاوزت كل ذلك، بالرغم من أنها لم تكن سوى شخصية وهمية في العالم الرقمي، إذن أين هي الشخصية الأصلية في خضم كل ذلك؟ أين هي أنصار؟ إن هذا ما دفعني لاغتيال آنا”.
صبيحة يوم بارد من أيام شهر كانون الثاني خلال هذا العام، حزم أوغور وأنصار علبة صغيرة تشتمل على صورة مطبوعة لملف آنا الشخصي على فيس بوك، مع سيف يستخدمه نظام الأسد كرمز، إلى جانب بعض الحلي والإكسسوارات، وتوجها بالسيارة صوب محمية طبيعية تقع خارج أمستردام، وهناك حفرا حفرة ودفنا تلك الشخصية، بوجود شخص برفقة كلب هاله ما يفعلانه، لكنه أصبح الشاهد الوحيد على موت تلك المفتشة الرقمية التي لا بد أن يثير عملها في هذا السياق مشاعر الفخر والاعتزاز في نفس أي جاسوس حقيقي.
يحدثنا أوغور عما جرى فيقول: “لا بد أن يخبرك علماء النفس والمعالجون النفسيون وأنت تمر بوقت عصيب أن تحول تلك الفترة إلى شعيرة، أي أن تحويل شيء ما إلى طقس أو شعيرة يساعدك على تجاوزه، وعلى التخلص منه نهائياً”.
كان الوقت قد حان بالنسبة لهذين الباحثين حتى يشرع كل منهما بالتركيز على المواد التي جمعاها ولم يتمكنا من معالجتها بسبب انشغالهما بشكل كبير بتلك الشخصية التي دفناها حديثاً في غابة ووقفا دقيقة صمت أمام قبرها.
تتذكر أنصار ما جرى يومئذ فتقول: “أضحك عليها طوال الوقت، فكلانا يتذكر آنا دائماً”.
المواجهة…
كان هنالك شيء آخر يجب عليهما فعله، وهو مواجهة أمجد بما يعرفانه عنه، إذ يتساءل أوغور هنا وهو يقول: “إلى متى يتعين على المرء التودد لضابط مخابرات؟ أعتقد أن اللحظة التي فتح قلبه فيها وتحدث عن أخيه، وعن أخذه بالثأر، هي أعمق نقطة يمكن الوصول إليها ضمن هذا السياق المحدد”.
وهكذا، وعبر تطبيق فيس بوك ماسنجر، استخدمت أنصار هويتها الحقيقية هذه المرة بدلاً من آنا، لترسل إلى أمجد تسجيلاً مرئياً مدته 14 ثانية، وتخبرنا عما جرى فتقول: “كان أول سؤال سألني إياه هو: هل هذا أنا الذي في الفيديو؟ فأجبته: نعم هذا أنت، فرد: أجل، هذا أنا، ولكن عن أي شيء يدور هذا الفيديو؟ لا شيء، فأنا أعتقل أحد الأشخاص، وهذا هو عملي”.
وعندما أدرك أمجد عواقب الفعل الذي عرض عليه، أخذ يتهجم على عناصر في جبهة الدفاع الوطني، أي تلك الميليشيا التي كان ذلك المجند الغر ينتمي إليها، حيث وصفهم بأنهم سفاحون وقتلة، وبأنه ليس مثلهم.
وبعدما كف عن المضي في تلك الحيلة، تبنى أمجد ما فعله بكل تحد حيث كتب في رسالة: “إنني فخور بما فعلته”، وذلك قبل أن يهدد أنصار هي وأسرتها بالقتل.
لم ترد أنصار ولا أوغور على أمجد منذ شهر شباط وقاما بحظره على حساباتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه حاول الوصول إليهما مرات عديدة، إذ من الواضح أنه قلق حيال ما سيحدث وما سيحل به مستقبلاً، وذلك لأن المحاكمات على جرائم الحرب في ألمانيا بدأت تكسر الدرع الحصين لحالة الإفلات من العقاب التي احتمى بها نظام الأسد في سوريا، ومع ذلك، لم تشتمل جلسات الاستماع في تلك المحاكمات على دليل دامغ مثل الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي يوثق مجزرة التضامن.
ولكن قبل أن تصل تلك القصة إلى الناس، كان لا بد من نقل شخص إلى بر الأمان، أي ذلك الشخص الذي سرب الفيديو إلى صديق له في فرنسا، ثم وصل ذلك الفيديو إلى أوغور وأنصار. وهكذا شرع ذلك الرجل في رحلة خطرة خلال الأشهر الستة الماضية.
هروب المصدر
إن ترك النظام في سوريا ليس بالأمر السهل، لأن كل من يطمح للسفر إلى أي منطقة في الداخل السوري، أو خارج البلاد على وجه الخصوص، يتم إخضاعه لعملية استجواب وتحقيق طويلة قبل السماح له بالسفر. وبالرغم من احتفاظ الأسد بالسلطة، فإن المناطق التي يسيطر عليها تقلصت كثيراً، كما أن اثنين من كبار الأمراء من أصحاب النفوذ، وهما إيران وروسيا، أصبحا يتمتعان بسلطة عرقلة كثير من قرارات الدولة السورية. إلى جانب احتفاظ فصائل المعارضة بسيطرتها على شمال غربي سوريا، في حين أقام الكرد درعاً لهم في شمال شرقي البلاد، أي أن سوريا بقيت ممزقة وبلا أي تسوية، فتحولت بذلك إلى مكان أصبح فيه أفراد العائلة الواحدة يشك بعضهم ببعض وينتظرون لخياناتهم أن تظهر.
وهذا ما حدث عندما سافر شاب سوري من العاصمة السورية إلى حلب خلال الأشهر الستة الماضية وذلك ضمن المرحلة الأولى لرحلته نحو الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة، ثم إلى تركيا، ومنها إلى فرنسا.
كانت الرحلة بالسيارة من دمشق إلى حلب رحلة شابها كثير من التوتر والقلق، فقد سمحوا له بالسفر إلى هناك، ولكن هل ستلحق به قطعات المخابرات المخيفة قبل أن يخرج من قبضتها؟ في ريف حلب الشمالي، حصل ضابط برتبة عقيد من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري على رشوة وقدرها 1500 دولار مقابل السماح لرجل بالعبور إلى أرض قفر تفصل بين الجانبين. ومع ذلك تأخرت الرحلة يوماً واحداً، بعدما جهزت الفرقة الرابعة شحنة كبتاغون حتى تعبر من الطريق ذاته. وبعد فترة قصيرة، وصلت شاحنة تحمل عشرات الكيلوغرامات من المنشطات التي يصنعها النظام ويوزعها ويصدرها إلى مختلف أرجاء الشرق الأوسط، لتشق طريقها إلى الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة.
سرعان ما لحق المصدر بتلك الشاحنة، وبعد مرور بضعة أسابيع، التقت به أنصار في تركيا، حيث قاما بملء فجوات في قصة التضامن بعد أسابيع من النقاش، وهكذا تم تجهيز مذكرات من أجل محاكمة على جرائم الحرب وترتيبها لرفعها أمام القضاء.
وفي شهر شباط، سلم أوغور وأنصار الفيديوهات والمذكرات التي لديهما، والتي تشتمل على آلاف الساعات من المقابلات، إلى النيابة في هولندا وألمانيا وفرنسا. وخلال الشهر ذاته، وتحديداً في ألمانيا، قامت أول محاكمة لضابط سوري آخر عمل لدى المخابرات العسكرية، وهو أنور رسلان، حيث تمت محاكمته على دوره في الإشراف على قتل ما لا يقل عن 27 سجيناً وتعذيب أربعة آلاف آخرين على الأقل، ثم أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد.
الثمن: النفي مدى الحياة
أصبحت أنصار تعامل معاملة الغريبة من قبل عائلتها، إذ إنها لم تعد كما كانت قبل بدء العمل على ذلك المشروع، لكنها تقول: “إن الأمر يستحق كل ذلك، صحيح أن العمل كان مضنياً وشاقاً، ولكني آمل أن يساعد عملي في إنصاف الآخرين”.
أصبحت التضامن اليوم جزءاً حيوياً وصاخباً من العاصمة وكأن الحرب لم تمر على عتباتها، إذ تمت تغطية كثير من الخراب والجرائم بوساطة المباني ومواقف السيارات، أو بأكوام من حطام الطائرات الحربية ومقذوفاتها التي ظهرت نتيجة النزاع. بيد أن أنصار وأوغور ما يزالان على قناعة تامة بأن هنالك كثيراً من المجازر التي ارتكبت في تلك المنطقة، ولهذا يقوم كل منهما بجمع مواقع وأسماء من فقدوا خلال الصراع الوحشي للسيطرة على تلك الضاحية.
يصف لنا أوغور ذلك بقوله: “يلقي الأهالي باللائمة على النظام، فهم يعرفون من قتل أحباءهم، إلا أن الغريب في الأمر هو أن من قتلوا في هذا الفيديو لم يكونوا من المعارضين، بل كانوا مع النظام بقلوبهم، إذ بوسعنا أن نشاهد كيف لم يتعرض أي منهم لحالة سوء التغذية، وقد أتوا من حواجز التفتيش مباشرة وليس من الأقبية والمخابئ، ثم قتلوا في عملية كانت أشبه بتحذير للأهالي حتى لا يفكر أي منهم بتغيير الطرف الذي انحاز إليه، ولهذا يستحق أهاليهم الإنصاف”.
في تلك الأثناء، وصل المصدر إلى مكان آمن خارج سوريا، ولكنه بهروبه من محيطه، أي الدائرة المقربة من نظام الأسد، حكم على نفسه بالنفي مدى الحياة، إلا أن أنصار تصفه بقولها: “إنه سعيد بقراره، إذ إن المرء يرغب بفعل ما هو صحيح في بعض الأحيان، وأنا إن تعلمت شيئاً من هذه التجربة فهو أن الخير ما يزال موجوداً لدى البشر، وما يزال بوسع الحقيقة أن تبصر النور في نهاية المطاف”.
المصدر: غارديان
ربى خدام الجامع | Ruba Khadam Al Jamee
تلفزيون سوريا

———————
قرابين التضامن/ أور أوميت أونغر , أنصار شحود
نقله إلى العربية: مهند أبو الحسن ودُمّر سليمان
في شهر نيسان (إبريل) من العام 2013، قام فرع المنطقة التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، والمعروف أيضاً بالفرع 227، بقتل أكثر من 280 مدني اقتيدوا إلى أحد أحياء دمشق المعزولة، وتم إعدامهم واحداً تلو الأخر في مقبرة جماعية كانت قد أُعدت مسبقاً. وأثناء توثيقهم للمجازر بتصويرها، لم يتوانَ الجناة عن أخذ لقطات تذكارية مروّعة. لم يكن من المفترض أن يتم تداول هذه المقاطع، ولكنّ مصدراً مقرباً منهم قام بتسريب هذه الفيديوهات لنا. وعلى مدار عامين، قُمنا بالتحقّق من حملة القتل تلك، حيث أجرينا تحليلاً لهذه المقاطع المصورة وعملنا على تحديد الموقع الجغرافي الذي وقعت فيه هذه المجازر، كما أننا استطعنا العثور على مُطلِق النار الرئيسي على منصة فيسبوك ونجحنا في إجراء سلسلة من المقابلات معه.
«لقد انتقمت، أنا لا أكذب عليكِ، لقد انتقمت، لقد قتلت. لقد قتلت كثيراً، قتلت كثيراً ولا أعرف عدد الأشخاص الذين قتلتهم».
أمجد يوسف
الفيديو الصادم
في شهر حزيران (يونيو) من العام 2019، كان أور أونغر يَحضرُ مؤتمراً أكاديمياً في باريس، حول الاستخدامات العلمية للمواد البصرية وشهادات الناجين وشهود العيان في حالات المجازر الجماعية. خلال هذا المؤتمر كان أور يستعد لتقديم عرض حول آلية معالجة المواد الفيلمية المتعلقة بجرائم الحرب، وأثناء انتظاره لتقديم مداخلته، تلقّى اتصالاً هاتفياً من صديق سوري أراد لقاءه بشكل عاجل. وفعلاً التقيا في ركن بعيد في أحد المقاهي الهادئة، أخرج الصديق السوري هاتفه وطلب من أور مشاهدة مقطع فيديو. كان مقطع الفيديو هذا، والمقاطع اللاحقة التي شاهدها مع مجموعة من الباحثين المخضرمين في أبحاث أعمال العنف والابادة الجماعية، صادماً بشدّة حتى بالنسبة لهم، إذ تتضمن هذه الفيديوهات عرضاً لتنفيذ عناصر من المخابرات العسكرية وقوات الدفاع الوطني عملية إبادة ممنهجة بحق مدنيين في حي التضامن الدمشقي في العام 2013 وبدايات 2014.
حي التضامن: سورية المصغرة
يقع حي التضامن خارج البوابة الجنوبية لمدينة دمشق القديمة، على أطراف حي الميدان الدمشقي، وإلى الجنوب الغربي من حي باب شرقي الذي يعتبر قلب الحياة الليلية الصاخبة لمدينة دمشق. ويقابل مفردة «التضامن» في اللغة الإنجليزية كلمة «solidarity»، في إشارة إلى هؤلاء الذين تشردوا نتيجة غزو إسرائيل لمرتفعات الجولان عام 1967. فقد بدأ هؤلاء النازحون بالاستقرار في الأراضي الزراعية جنوب العاصمة دمشق، في المنطقة الواقعة ما بين حي الميدان الدمشقي ومنطقة السيدة زينب، حيث قاموا ببناء منازلهم بشكل عشوائي وبإمكانياتهم الخاصة بالإضافة إلى دعم حكومي محدود بشدّة. وفي وقت لاحق، تم الاعتراف بالحي بأثر رجعي باعتباره جزءاً من حي الميدان وبلدة يلدا، ويأخذ اسم حي «التضامن».
في تسعينيات القرن الماضي، تدفقت موجات اليد العاملة الريفية المهاجرة من كافة أرجاء سوريا باتجاه العاصمة دمشق، ثم تدفّقت موجات أخرى نتيجة الجفاف التي أثَّرَ بشكل حاد على القطاع الزراعي في البلاد في العام 2003، وأجبرَ العديد من المزارعين اليائسين على ترك أراضيهم في محاولة إيجاد سبل النجاة في دمشق. استوعبَ حي التضامن جزءاً كبيراً من الهجرات الداخلية المتعاقبة، التي أسست ديناميات عائلية سهلت استقرار القادمين الجدد، وأثّرت بشكل كبير على تشكيل التركيبة الاجتماعية والديمغرافية للحي، الذي أصبح منطقة عشوائية كبيرة ذات أعلى نسبة كثافة سكانية في دمشق.
ومع أن الحي بغالبيته العظمى من العرب السنة، إلا أنه استوعبَ أيضاً العديد من الطوائف الدينية والعرقية الأخرى كـ: العلويين والدروز والإسماعيليين والتركمان والأكراد… إلخ. لكن التمايزات بين هذه التجمّعات تشكلت على أسس مناطقية أكثر من كونها انتماءات طائفية، أو بشكل أكثر تحديداً، على التراكب ما بين هذين العاملين. فعلى سبيل المثال: يُنسَب علويو شارع نسرين إلى قريتهم الأصلية عين فيت التي نزحوا منها في مرتفعات الجولان المحتلّ، كما ينتسب دروز شارع الجلاء إلى قراهم التي نزحوا منها في الجولان أيضاً. هكذا يصبح تحليل التمايزات السوسيو-مجالية (socio-spatial)، التي شكلتها هذه التجمعات المتجانسة والمتنافسة معاً، عاملاً مهماً لفهم آليات العنف الجماعي في حي التضامن.
لطالما أشارت كبرى وسائل الإعلام الرسمية السورية إلى حي التضامن بوصفه «سوريا المصغرة»، لكن هذه الإشارة لم تكن متعلّقة بنشأة الحي أو تكوينه الاجتماعي، بل بوصفه الواجهة «العلمانية» المفترضة للنظام السوري، بالإضافة إلى كونها مادة خطابية عن التعايش السلمي في البلاد، إلا إن الحي شكّل في الواقع مساحةً متناقضة. فعلى الرغم من تواجد سوريين من خلفيات طائفية وعرقية وسياسية ومناطقية متنوعة يعيشون معاً بألفة فيه، إلا إنه كان في الوقت نفسه بيئةً متوترةً شديدة الاستقطاب. فحي التضامن من الأماكن القليلة التي يكون فيها الجناة والضحايا جيراناً، إذ إنه موطن العقيد سيء السيط علي خزام، 1
كيف صاغت هذه التعقيدات الصراعً في الحي؟
ساهمت الانقسامات الاجتماعية بلا شك في زعزعة الثقة بين المجموعات المختلفة، فليس هناك ما يميز حالة التعايش المرتبك هذه، نظراً لوجود حالات مماثلة في جميع أنحاء العالم، ولكن النظام السوري لم يستطع أن يستثير العداء والتوترات ما بين التجمعات إلا في ظل تنامي الاستقطاب بعد العام 2011، حيث حدّد هذا الاستقطاب الحاد المتصاعد بين الجيران أنماط التعبئة المتمايزة لسكان الحي.
ومع انطلاق التظاهرات في مختلف أحياء دمشق في ربيع العام 2011، شهد حي التضامن احتجاجاتٍ سلمية قصيرة ومتفرقة افتقرت إلى التنظيم في كثير من الأحيان، إذ انقسمت حركة الاحتجاج فعلياً وفقاً للبعد المناطقي للجماعات المنظِّمة. في لحظة معينة، كانت هناك ثلاث تنسيقيات مختلفة في الحي. والحال كان شبيهاً بين التجمعات الموالية للأسد، حيث انقسمت بدورها إلى ميليشيات متنافسة. بالمحصلة، قُسّمت المنطقة في النهاية إلى ما لا يقل عن ثلاث عشرة منطقة عسكرية منفصلة (قطاع)، يسيطر عليها أمراء حرب مختلفون. نستطيع القول بأن حي التضامن قد شهد دورة العنف المألوفة في النزاع السوري، أي انطلاق مظاهرات واجهها النظام بالقمع، فعسكرةٌ من طرف المعارضة أعقبها تصعيدٌ من قبل النظام.
ردَّ النظام على مظاهرات عام 2011 عبر إنشاء مجموعات الشبيحة، وهي ميليشيات موالية للنظام، قامت بقمع الاحتجاجات بطريقة شديدة العنف. يرتدي عناصر هذه الميليشيات عادةً ملابس مدنية، ويتم اختيارهم عشوائياً من بين فئة الشباب ذوي الخلفيات الأقلوية. إن أفعال هذه المجموعات موثّقة بشكل جيد جداً، من خلال مقاطع الفيديو والتسريبات والاعترافات والانشقاقات، بالإضافة إلى شهادات الضحايا. وتُظهر هذه التوثيقات ممارسات الشبيحة أثناء اقتحام الأحياء وتفريق المظاهرات ومصادرة الممتلكات وتعذيب الموقوفين، وصولاً إلى أعمال الخطف والاغتيال والمجازر الجماعية. 2
قد يبدو أن مجموعات الشبيحة ظهرت بشكل مفاجئ، إلا إن النظام السوري هو الذي تغاضى عن أفعالها وحرّضها ووجّهها ونظّمها، وقام بهيكلتها تدريجياً عبر نظام الزبائنية والمحسوبية الذي طوره. وكان من الواضح أن النظام أوكلَ لهذه الميليشيات مهمة القيام بالأعمال القذرة، لكي يتسنى له في وقت لاحق إنكارها.
قام النظام بإضفاء الطابع الرسمي على مجموعات الشبيحة من خلال إدراجها تحت ما سمي «قوات الدفاع الوطني» في شتاء العام 2012، حين مُنحت هذه المجموعة صلاحية إقامة نقاط التفتيش لتقوم باعتقال واحتجاز الأشخاص دون حسيب أو رقيب مع الإمكانية التامة للإفلات من العقاب، بالإضافة إلى صلاحياتهم السابقة باستخدام السلاح وقتل المتظاهرين. ولا بد من الإشارة إلى أن أحد أبرز قادة الشبيحة في الحي كان من بين مرتكبي المجازر الجماعية التي وقعت في المنطقة.
وعلى الرغم من الكفاءة العالية التي أبداها النظام في قمع المدنيين، إلا إنه لم يكن يبدي الكفاءة ذاتها على المستوى العسكري، الأمر الذي ظهر جلياً في العام 2012 من خلال خسارته بشكل مطرد لسيطرته على مساحاتٍ واسعةٍ في كافة أرجاء سوريا. ومع حلول بدايات العام 2013، كانت تقريباً نصف مساحة البلاد تحت سيطرة مجموعات مختلفة من مسلّحي المعارضة. اقترب خط المواجهة في منطقة دمشق وريفها من المدينة، نظراً لأن معظم الغوطة الشرقية والضواحي الجنوبية كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة.
في شهر شباط (فبراير) من العام نفسه، شنت فصائل المعارضة هجوماً مُنسّقاً واسع النطاق على كفر سوسة من جهة الجنوب ومن جوبر في جهة الشرق، ولو قُدِّرَ لهذا الهجوم النجاح لأصبحت القوات المُهاجِمة في مواجهة مباشرة مع أفرع المخابرات الرئيسة للنظام في كفرسوسة. وعلى الرغم من فشل الهجوم، إلا إن شبح الهزيمة المحتملة كان قد بدأ يلوح في الأفق بشكلٍ جدي، والأهم من ذلك أن خطوط المواجهة قد وصلت إلى حي التضامن.
دليل لا يقبل الشك: المجزرة
قام كل من أمجد يوسف ونجيب الحلبي، في 16 نيسان (أبريل) من العام 2013، بإعدام 41 شخصاً عبر الإلقاء بهم في حفرة تم إعدادها مسبقاً لهذا الهدف في وسط أحد الشوارع «غير المأهولة» في حي التضامن، وبعد الانتهاء من إطلاق النار على الضحايا واحداً تلو الآخر، أضرمَ الجناة النار في جثث ضحاياهم عبر إحراق إطارات سيارات وُضعت مُسبقاً في قعر الحفرة. أُنجزت المجزرة في يوم واحد، وقام الجناة بتصوير تفاصيل المذبحة كاملة.
كان أمجد يوسف يرتدي زياً عسكرياً أخضر اللون وقبعة صيد، مبدياً درجةً عاليةً من التركيز والهدوء والدقّة الخالية من المشاعر. وكان يُنفّذُ «عمله» هذا «بكفاءة» عالية مُنجِزاً المهمة في غضون 25 دقيقة، فيما كان زميله نجيب الحلبي يرتدي زياً عسكرياً رمادي اللون وتبدو على ملامحه علامات الارتياح. كان يدخن، بل ويتحدث أحياناً بشكلٍ مباشرٍ إلى عدسة الكاميرا.
كانت عملية إعدام الضحايا تتم بشكل روتيني تماماً، حيث يقوم أحد الجناة بإخراج الضحية معصوبة العينين من سيارة بيضاء صغيرة مخصصة للنقل الجماعي «سرفيس»، ثم يقتاده إلى الحفرة الكبيرة المفروشة بالكامل بإطارات السيارات، ويلقي به في هذه الحفرة، ليقوم الآخر بإطلاق النار عليه من خلال بندقية حربية من طراز AK-47 وفي بعض الحالات بواسطة مسدس.
نفَّذَ الجناة عمليات الإعدام هذه بأسلوب إجرائي اعتيادي دون أن يتبادلوا الحديث إلا فيما ندر. كانت صرخاتهم وأوامرهم تتوجه للضحايا: «قوم» «طلاع» «مشي» «اركض». ولم يُبدِ القتلة أي درجةٍ من درجات التعاطف مع الضحايا، بل نستطيع القول إننا نَلمَحُ درجةً من الاستمتاع وهم يقومون بذلك. خلال مجريات تصوير المجزرة، يتوجه نجيب إلى عدسة الكاميرا مخاطباً «رئيسه»: «لعيونك يا معلم ولعيون البدلة الزيتية اللي م تلبسها».
من الواضح أن الجناة قد أعدّوا موقع الإعدام هذا بشروط مثالية من أجل استخدامه المتكرر، ليس فقط لتنفيذ عمليات الإعدام، بل وأيضاً من أجل إحراق الجثث وعدم ترك أي أثرٍ لها. كما يبدو أن مرتكبي المجزرة مرتاحون تماماً أثناء تنفيذ عملهم في وضح النهار، مما يشير إلى أن موقع المجزرة يقع تحت سيطرتهم الكاملة، حيث لا تبدو عليهم العجلة، وليسوا مُعرَّضين لأي تهديد.
في سياق هذه المجزرة، يقوم الجناة بإيهام بعض الضحايا بأنهم يمرون عبر منطقة معرضة لنيران القنّاصة، فيصرخ نجيب مخاطباً ضحيته: «قنّاص يا عرص» دافعاً إياه نحو الحفرة ومُطلِقاً النار عليه بينما لا يزال في الهواء أثناء سقوطه. فيما يبدي أمجد درجةً من نفاد الصبر لأن أحد الضحايا لم يَمت لا من الطلقة الأولى ولا من الثانية، وبعد الطلقة الثالثة يصرخ مخاطباً الضحية «موت يا عرصة، ما شبعت؟». تُشير نهاية الفيديو إلى انتهاء هذه المجزرة حيث يسأل أحد الجناة: «في غيرو؟»، ليَسودَ صمتٌ لا يقطعه سوى أنينٌ خافتٌ صادرٌ عن كتلة الجثث تحت أحذية الجناة.
في فيديو آخر، يظهر أمجد يوسف وهو يقود الجرافة التي تحفر المقبرة الجماعية بعمق ثلاثة أمتار. تم قصف الشارع الذي وقعت فيه المجزرة في وقتٍ لاحق، ليبدو المشهد وكأنه دمارٌ شاملٌ جراء القصف والتفجير والاشتباكات. تظهر ثقوب الرصاص على الجدران، فيما تبدو الأجواءُ خلال الفيديو هادئة بدون أصوات للحرب أو القصف أو الاشتباكات؛ هدوءٌ لا تقطعه سوى أصوات طلقات النار التي تستهدف الضحايا، بالإضافة إلى الدخان المتصاعد من فوهات بنادق القتَلَة.
أمجد يقود جرافة الجريمة
يأخذ المصوّر وقته في التقاط مَشَاهِده، حيث يركّز في أغلب الأحيان على المقبرة الجماعية، وعلى عملية إحضار الضحايا وإطلاق النار عليهم واحداً تلو الأخر.
يُملَأُ القبر بسرعة ويتحوّل إلى فوضى متشابكة من الجثث والملابس والدم وإطارات السيارات، وبعد بضعة دقائق تَصعُب مشاهدة اللقطات ويَصعُب وصفها بالقدر ذاته.
كانت أعينُ الضحايا معصوبة إمّا بشريط لاصق أو بغلاف بلاستيكي، كما أن أيديهم كانت مُقيَّدةً برباطٍ بلاستيكي يُستخدم عادة من أجل جمع وتثبيت الكابلات الكهربائية. تُستخدم هذه الأربطة في جميع أرجاء العالم كأصفادٍ بلاستيكية. يرتدي معظم الضحايا ملابس غير رسمية: جينز وقمصان وبدلات رياضة ودشاديش، فيما يرتدي عددٌ آخرٌ منهم ملابس منزلية مما يدل على توقيفهم إما من منازلهم أو من نقاط التفتيش القريبة إليها. كما أن الفقر المدقع يبدو على بعضهم، فيما البعض الآخر يبدو حسنَ الهندام. كما تُظهر الفيديوهات بأن هؤلاء الضحايا لم يتعرضوا لتعذيبٍ شديد، ولا وجود لعلامات هزال كالتي تظهر على المعتقلين الذين يحتفظ بهم النظام في معسكرات اعتقاله، مما يشير إلى حداثة توقيفهم. لا يُبدي الضحايا أية مقاومة تذكر، فهم يطيعون الأوامر بكل استسلام، يخرجون، يمشون ويقفون دون ينطقوا ببنت شفة. قُتلَ الضحايا جميعاً بإطلاق النار عليهم، باستثناء رجل كبير في السنّ قتله أمجد يوسف ذبحاً.
يُقتَلُ الضحايا بصمت، مع قليل من التوسل والبكاء والصياح. يحاول بعضهم المساومة أو التسوية، ولكن أياً منهم لم ينطق الشهادتين قبل موته. كان الجناة يقومون بدفع البعض دفعاً، بينما يتم ركل الآخرين في الحفرة ليتم إطلاق النار عليهم بعد أن تستقر أجسادهم فوق جثث من سبقوهم، وفي بعض الحالات كان يتم إطلاق النار على الضحايا وهم في الهواء أثناء سقطتهم الأخيرة. أحد الضحايا توسّلَ لأمجد قائلاً: «بحياة الإمام علي»، لكن أمجد لم يرحمه وقذف به في الحفرة قائلاً «لعنك الله يا إبن الشرموطة». عجوزٌ يسير مترنحاً ليرتطم بالجدار، وتنزلق قدمه في الحفرة مطلقاً صرخة ألم مستنجداً بوالده: «يا باي»، شابٌ يستطيع تحرير يديهِ من القيد أثناء سقوطه؛ امتدّت يده محاولاً رفع العصابة عن عينيه قبل أن يرديه أمجد برصاصة في الرأس. تتحرك بعض الأجساد في الحفرة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولكن زملاء أمجد يوسف يمسكون بنادقهم «الكلاشنكوف» بيدٍ واحدةٍ، ويمطرون برصاصهم الجثث في الحفرة.
ست من الضحايا النساء السبع اللواتي يظهرنَ في التسجيل كُنَّ يرتدين الحجاب والمعطف، اللذين يميزان النساء المسلمات التقليديات. هؤلاء النسوة كُنّ يقتلن بوحشية وعدائية لا يبديها القتلة تجاه ضحاياهم من الرجال. بشكلٍ مفاجئ تصرخ إحدى النساء صرخة استغاثة، ولكن نداءها لم يصل إلى أذني قاتلها، بل أجابها قائلاً: «قومي ولك شرموطة»؛ يسحبها من شعرها ويلقي بها في الحفرة مُطلِقاً عليها النار. تصرخ امرأتان صرخة خوف وهلع، ليقوم أمجد بركلهما نحو الحفرة وقتلهما، فيما الأخريات واجهنَ مصيرهنّ بكل صمت.
في فيديو آخر، تتحرك عدسة الكاميرا فوق أجساد مجموعة من الأطفال وسط غرفة مظلمة، يتحدث أمجد يوسف قائلاً بإيجاز: «أطفال كبار الممولين في ركن الدين، تضحية لروح الشهيد نعيم يوسف».
بلغ عدد الضحايا الإجمالي 288 ضحية في مقاطع الفيديو الـ27 التي بحوزتنا، معظمهم من الشباب أو ممّن هم في منتصف العمر، بالإضافة إلى بعض الأطفال والنساء وكبار السن. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من السنّة (بما فيهم التركمان) 3
وفق فهم الجناة وولائهم، فقد كان الذكور متوسطي العمر السنّة موضع شك ما لم يؤكدوا ولاءهم وطاعتهم لـ «الأسد». بخلاف ذلك، كان يُنظَر إلى الجميع على أنهم متعاطفون أو عملاء متخفّون أو مؤيدون محتملون للمعارضة، وقد كان الجميع يُعامل على هذا الأساس. ووفقاً للعديد من الشهادات التي حصلنا عليها، يبرر الجناة ذلك باحتفال السكّان التركمان بدخول الجيش الحر إلى الحي. عدا أن هذا التبرير ليس إلّا خيالاً مبالغاً فيه، فإن جميع الضحايا الذين تم التعرف عليهم كانوا متنوعين ينتمون إما إلى الطبقة العاملة أو الطبقة الوسطى.
تؤدي الشهادات التي حصلنا عليها إلى استنتاج أن الضحايا هم ممن اعتقلوا في حي التضامن أو على الحواجز المحيطة به، ليتم نقلهم إلى موقع المجزرة وتصفيتهم على تلك الشاكلة. ومن المرجّح أن أياً منهم لم يتخيل حدوث ذلك، بل وربما اعتقدوا أنهم آمنون، أو أنهم حتى لم يفهموا بتاتاً سبب حدوث ذلك.
دراسة المجزرة
تركتنا مقاطع فيديو المجزرة في حالة من الصدمة والحيرة: متى وأين حدث هذا؟ من كان القتلة ومن هم الضحايا؟ لماذا حدث كل هذا؟ واجهتنا مجموعة من التحديات الأخلاقية والعملية، نظراً لصعوبة دراسة عنف الأنظمة الاستبدادية كنظام الأسد. إذ كيف يمكن المناورة مع الطبيعة القمعية المتكتّمة للنظام؟ وكيف سنتعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة علينا كباحثين، وعلى الذين سنجري معهم المقابلات؟ وهكذا بدأت مقاربة محددة بالتشكل، تعتمد منهجية متعددة الطرق، تدمج التاريخ الشفوي ومقابلات إثنوغرافية سرّية مع عملية تحليل مرهقة لمقاطع الفيديو وبيانات المصادر المفتوحة. كما قمنا بإجراء مقابلات شخصية في كل من برلين وغازي عنتاب وإسطنبول، إضافةً إلى المقابلات الافتراضية عبر وسائط التواصل الاجتماعي (فيسبوك، واتساب، سيجنال، وزووم)، وأخيراً استعنّا بوسيط يقيم في دمشق ليقوم بالبحث الميداني.
بدأنا بالمقطع الرئيس لعمليات الإعدام، وكان هناك دليلٌ واحدٌ جيد على الوقت الدقيق للمجزرة، فأحد ملفات الفيديو حمل ختماً زمنياً يُشير إلى 16-4-2013. إلا أن التحديد الدقيق لموقع القتل كان أكثر صعوبةً، فقد حُفِرَت المقبرة الجماعية في شارع ضيّق نسبياً، يشير طابعه الحضري وهندسته المعمارية إلى أنه مكانٌ ما من ضواحي دمشق، ولكن من غير الواضح إن كان في غوطة دمشق الشرقية أو في ضواحيها الجنوبية. ثم استطعنا رؤية المزيد، فقد كان للبناء المقابل لحفرة الإعدام سقفٌ أحمر وشرفة زرقاء، مع رسم شجرة نخيل على أحد الجدران. لكن المنطقة كانت مدمرة كلياً، مما لا يدع مجالاً للتعرّف على أي شيء آخر، فلا يمكن مشاهدة دكان او إشارة أو معلم بارز. ومن خلال مُشاهدة مقطع الفيديو مرة تلو الأخرى، لاحظنا عبارة «فتح بلد يلدا 14/3/2012» منقوشة على أحد الجدران خلف الجاني. تثير هذه العبارة، التي رسمتها على الأغلب إحدى فصائل المعارضة بدهان بخاخ، احتمال أن الموقع المنشود يقع في جنوب بلدة يلدا التي سقطت بيد الثوار في وقت سابق من العام 2012. (اتضح لاحقاً أن الموقع هو منطقة الطبقة العاملة في حي التضامن المجاور، لكن تلك كانت مجرد بداية). دَفعَنا هذا الدليل إلى التواصل مع نشطاء المعارضة والفصائل المسلحة التي نشطت هناك.
وبما أننا لا نستطيع السفر إلى سورية، قمنا بالاستعانة بباحث مساعد يمتلك الخبرة وشبكة علاقات ضمن مجتمعات الضحايا. استطاع باحثنا المساعد أن يستكشف المنطقة ويصوّرها بالفيديو سراً، كما أنه بحث عن الضحايا ورتَّبَ مقابلاتٍ سرية مع الناجين منهم. أُجريت المقابلات وسُجِّلَت بواسطة برمجيات آمنة نسبياً، ودُوِّنت أسماء من أُجريت معهم المقابلات ومعلوماتهم التعريفية بشكل منفصل، ثم مُسحت من التسجيلات. اتّبعنا أكثر تدابير الأمن السيبراني المتوفرة لدينا صرامة. كما شملت المقابلات الرقمية شهود عيان ومدافعين عن حقوق الإنسان ومقاتلين سابقين في الجيش السوري الحر. عرضنا صوراً أخذناها من مقاطع الفيديو على من أجرينا معهم المقابلات، مما سرَّعَ نسبياً عملية تضييق نطاق البحث وحصرها بشارع دعبول في التضامن. وتقاربت الروايات لتحديد المكان بالقرب من مسجد عثمان في «حارة البرادي»، وهي منطقة كانت تحت سيطرة النظام طيلة فترة النزاع الذي قسم الحي إلى منطقتين بواسطة خط جبهة ثابت نسبياً، تَحدَّدَ في تاريخ المجزرة بالقرب من جامع عثمان وصولاً إلى سينما النجوم. هنا، كنا قد استوفينا حدود قدراتنا لتحديد الشارع بدقة، فطلبنا مساعدة تقنية من مُحللي بيانات المصادر المفتوحة وخبراء تحديد المواقع الجغرافيّة، الذين بدورهم قدموا أدلةً قاطعةً، أكدت افتراضاتنا، على أن المجازر وقعت بالقرب من مسجد عثمان في التضامن استناداً إلى أعمدة البناء التسعة المجاورة لحفرة المقبرة.
ولكن من هم هؤلاء الجناة؟ ولماذا ارتدى القاتلان الرئيسان بزّتين عسكريتين مختلفتين؟ قد يدلّل هذا على عمل مشترك بين جهازين أمنيين أو عسكريين مختلفين، ولكنهما لم يحملا أي إشارات تعريفية أو رُتَب على أكتافهما. وفي أحيان قليلة، كان من الممكن التعرف على لهجة مناطقية معينة، لكنهما بالمجمل كانا يتحدثان العربية باللهجة الدمشقية «المحايدة»، ولم يقدم أي شيء قالاه دليلاً على هويتهما الشخصية أو المهنية، إذ لم يخاطب أحدٌ منهم الآخر. كانت المهمة الملقاة أمامنا شاقة، إذ علينا التعرف على الأجهزة التي كانت مسؤولةً عن المنطقة، ومحاولة تحديد مواقعهم بواسطة الإنترنت من خلال وسائل الإعلام الموالية للنظام، أو عبر مجموعات الفيسبوك الغامضة الناطقة باسم الأجهزة الأمنية.
أصبحَ فيسبوك منصةً شعبيةً بين السوريين الموالين للنظام منذ 2011، ومن بين هؤلاء كان الجناة ومنتهكو حقوق الإنسان الذي غالباً ما يشاركون عبره قصصهم وصور رفاقهم المتوفين. وكان السؤال المُلحّ: كيف يمكننا استخلاص معلومات منهم دون المساس بأمن أي أحد؟ وقد حالَفنا الحظ إذ إننا كنا قد أنشأنا مسبقا في العام 2018 ملفاً شخصياً على فيسبوك لفتاة شابة موالية للنظام، من عائلة علوية تنتمي إلى الطبقة الوسطى من حمص أسميناها «آنّا». وكان الغرض من هذه الهوية الافتراضية هو مراقبة منتهكي حقوق الإنسان السوريين عن كثب في بيئاتهم على الإنترنت، والتمكّن من التواصل المباشر معهم بغية إجراء مقابلات. صُمّمت شخصية آنّا ومنشوراتها على فيسبوك بعناية لتتناسب مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي للجناة (ecosystem) أياً كانت هويتهم، فمن الصعب التشكيك في دوافع فتاة علوية من الطبقة الوسطى من حمص، تدرس النزاع السوري في الخارج. حققت آنّا نجاحاً باهراً، إذ مكّنتنا من إجراء مقابلات مع العشرات من الأسديين مرتكبي جرائم، بمن فيهم بعض الرتب الرفيعة نسبياً.
عندما حصلنا على فيديو مجزرة التضامن كانت آنّا بالفعل جزءاً لا يتجزأ من الدوائر الفيسبوكية الموالية للنظام، وقد شملت قائمة أصدقائها عدداً من الجنود ورجال الميليشيات والضباط ورجال الأعمال والإعلاميين، بل وحتى بعض عناصر أجهزة المخابرات.
حساب آنّا على فيسبوك
إذا أخذنا بعين الاعتبار الاحترافية الروتينية لعمليات القتل المُصوَّرة، والمكانة البارزة التي تحتلها الأجهزة المخابراتية في منظومة عمل نظام الأسد، وبالإضافة إلى أن عمليات قتل جماعي كهذه، تستوجب قدراً من الحساسية والحذر، كانت تنفذ في وضح النهار، يصبح من المحتمل جداً أن واحداً على الأقل من مطلقي النار ينتمي إلى أحد الفروع الأمنية. وبما أننا ألقينا نظرةً فاحصةً على وجوه القتلة (وهو أمرٌ فاق قدراتنا النفسية)، بدأنا استعراض صفحات الفيسبوك الخاصة بالجيش والمخابرات والميليشيات التي كانت عاملةً في منطقة يلدا، وجنوب دمشق على نحو أوسع، لربما نصادف وجهاً مألوفاً، لكن هذا كان كالبحث عن إبرة في كومة من القش. كان لدينا عدد قليل جداً من الأدلة، ليس من بينها اسم أو رقم الفرع الأمني الذي ينتمي له أيّ من القتلة. وقد استطاع عددٌ ممن أجرينا معهم المقابلات التعرف إلى مطلق النار الرئيسي، ولكنهم أشاروا إليه باسمه الحركي المخابراتي «أبو علي»، بينما لم يستطيعوا استذكار اسمه الكامل أو أية تفاصيل أخرى. سعينا لأشهر دون جدوى، وبدأ صبرنا يتحول تدريجيا إلى يأس.
ثم، في أحد الأيام، تعرّفنا على مطلق النار الرئيسي في صور لعناصر من فرع المنطقة التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، وهو ما يعرف أيضاً باسم الفرع 227.
مقابلة مع الجاني
القاتل هو شاب، صف ضابط في المخابرات العسكرية اسمه أمجد يوسف، يمكن التعرف عليه بسهولة بسبب ندبةٍ أفقية على حاجبه الأيسر. نظر إلى الكاميرا مباشرةً في فيديو المجزرة، وكانت صورته واضحةً جداً. وبعد تصفح ملفه الشخصي على فيسبوك، الذي ضُبطت منشوراته بحيث تكون متاحة للعموم، أرسلنا له طلب صداقة. كان بالتأكيد هو. لقد تغير مظهره الجسدي قليلاً، إذ اكتسب جسدُ مطلق النار النحيل ذي الزي العسكري بنيةً عضلية. كان ملفّه الشخصي على فيسبوك يطابق تماماً نمط منتهكي حقوق الإنسان السوريين، منشوراته كانت صوراً للأسد الأب والابن، لقطاتٍ لأصدقائه، مناظر خلّابة لقريته، صور شخصية أثناء ممارسته الرياضة في النادي، والأهم من ذلك كله، منشورٌ حزينٌ نعى فيه صديقه وزميله «نجيب الحلبي»، والذي كان من السهل التعرف عليه على أنه مطلق النار الثاني. لقد غمرتنا البهجة إذ وجدنا «الشريكين» اللذَين بحثنا عنهما لأشهر.
أمجد يوسف في مكتبه
قَبِلَ أمجد طلب صداقة «آنّا»، وكان حذراً، إلا إن فضوله لمعرفة لماذا وكيف تواصلنا معه كان أيضاً واضحاً. وافق على التحدث إلينا 4
بعد أن شرحنا له بعباراتٍ عامة أننا نُجري أبحاثاً أكاديمية عن سياق النزاع السوري، وأننا تواصلنا معه لأنه يبدو «في الجيش». وبهذا بدأنا سلسلة من المحادثات استمرت ستة أشهر، تبادلنا أثناءها الحديث مع أمجد، وخلالها أيضاً أجرينا مقابلتي فيديو مطوّلتين معه.
أثناء المقابلة الأولى، كان أمجد في الفرع يجلس مرتديا لباساً مدنياً إلى مكتبٍ تعلوه صورةٌ لبشار الأسد معلقةً على الحائط الخلفي. كانت هذه المحادثة الأولى لنتعرف على بعضنا بعضاً، وقد حرصنا على عدم استخدام مصطلح «مقابلة»، بل أسميناها «تعارف». كان متوتراً بعض الشيء، وبعد تبادل المجاملات الاعتيادية قام باستجوابنا أكثر مما أتاح لنا أن نطرح عليه أسئلتنا. لم يُدرك أمجد أن سلوكه بحد ذاته كان أحد مواضيع بحثنا. ولكن بغض النظر عن هذا كله، كنا قادرين على النظر من خلال شاشتنا في عيون منتهكٍ حقيقي لحقوق الإنسان يجلس إلى مكتبه، ينظر إلينا من خلال شاشته ويعبث بكمبيوتر موضوعٍ على مكتبه، ويرفع سماعة الهاتف ليطلب فنجان من القهوة كلما رغب بذلك. في نهاية اللقاء بدا أنه قد اقتنع بروايتنا ووافق على محادثة ثانية. 5
كانت المقابلة الثانية أكثر إفادةً وإثارةً للاهتمام. تحادثنا في وقتٍ متأخرٍ من الليل. كان أمجد على أريكةٍ في منزله، يرتدي قميصاً داخلياً (شيّال أبيض)، يدخن بشراهة، ويحتسي مشروباً ما بينما يتناول وجبةً خفيفةً من الخيار. أخبرنا أنه ولد عام 1986 في قرية نبع الطيب العلوية في منطقة الغاب وسط غرب سوريا، على بعد 70 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة حماة. وهو الابن الأكبر لعائلة مكونة من عشرة أخوة وأخوات تربوا جميعاً بشكلٍ صارمٍ على تكريم التراث الديني العائلي لجدهم الأكبر، الذي كان من الشيوخ العلويين البارزين. وقد مارس أمجد مع أخوته وأخواته مراراً الطقوس الدينية في مقامات بني هاشم المحاذية لقريتهم. أثّرت هذه التنشئة الدينية على تصوره لذاته وللآخر، لكنها لم تكن الدافع الرئيسي خلف أفعاله.
أمجد يوسف أثناء المقابلة الثانية
حَدَّثنا أمجد أنه التحق بمدرسة المخابرات العسكرية الواقعة في منطقة ميسلون في ضاحية الديماس في دمشق عام 2004، وأمضى فيها تسعة أشهر من التدريب المكثّف. كان العمل لصالح المخابرات العسكرية بالنسبة لأمجد ذي الثمانية عشر ربيعاً حينها الفرصة الأفضل لتحصيل حياةٍ مختلفةٍ عن أسلافه، الذين عانوا مشقة العمل في حقول التبغ لكسب لقمة معيشتهم. لم تتخطَ أحلام أمجد أكثر من رغبةٍ في الحياة كشخصٍ من الطبقة الوسطى، يمتلك منزلاً وعائلةً وسيارة. كان لدى أمجد رغبة خفية أن يتحرر من والده، ذاك الشيخ العلوي الذي اختار العزلة بعد تقاعده من عمله كعنصرٍ في الجيش والمخابرات. وبدلاً من أن يحرره العمل في المخابرات من واقعه، أدى ذلك إلى ترسيخه أكثر في المجتمع الموالي للنظام، وحوّله إلى «ابن المؤسسة». وخلافاً لطموحه أصبح «الولد سرّ أبيه». لم يستطع أمجد خلال مقابلاتنا معه -وهو الآن في سن السادسة والثلاثين- ألّا يعبر عن خوفٍ دفينٍ من والده، وأخبرنا أحد نُدمائه أن أمجد لم يجرؤ يوماً على التدخين في حضور والده.
حقَّقَ أمجد نجاحاً مهنياً لافتاً مع مطلع الألفية الجديدة، واستطاع دائماً أن يضمن لنفسه الترقية، ليكون في العام 2011 صف ضابط «مُحقِّق» يعمل بساعات دوام مكتبية ثابتة في فرع المنطقة أو الفرع 227. يعتبر هذا الفرع الكئيب الواقع في منطقة كفرسوسة مسؤولاً عن اعتقال وتعذيب وقتل الكثير من معارضي النظام السياسيين.
غير أن اندلاع انتفاضة عام 2011 غير حياة أمجد يوسف، إذ تم تعيينه في قسم العمليات ليكون مسؤولاً عن قيادة العمليات العسكرية على خطوط الجبهات في ضواحي دمشق الجنوبية، وتحديداً بين العامين 2011 و2021 كان المسؤول عن أمن خطوط الجبهة في منطقتي التضامن واليرموك. وخلال بحثنا تمكنّا من العثور على بعض المواد المصورة الدعائية المنشورة لهذه العمليات، حيث يظهر أمجد في أحد مقاطع الفيديو بعيون عابسة متجهمة، وسيجارة بين أصابعه أثناء حديثه مع مجموعة من المقاتلين المتحمسين لاقتحام حي التضامن.
وبخنَا أمجد خلال المقابلات لأننا نستخدم كلمة «مخابرات»، وطلب منا استخدام مصطلح «الجيش» أو «القوات المسلحة» عوضاً عنها:
«لم يكن هناك أثناء الأزمة أي شيء اسمه مخابرات، كان كلّه جيش. أنا كنت عنصر مخابرات، ولكن عملي كان كما يفعل الجيش، كانت مهمتي كما مهمات الجيش. مهنتي ليست قتال الشوارع والاقتحام والقصف …إلخ. هذه كانت مهنتي أثناء الأزمة. لم يكن هناك أي شيء خلال هذه الأزمة اسمه مخابرات، كنا كلنا جيش، مهماتنا كانت نفسها» 6
تُخبرنا حساسية أمجد المفرطة لاستخدام كلمة «مخابرات» تحديداً ما يمكن أن يكتب عنه مجلداتٌ عدة، فهذه الحساسية لا تدل على إنكار وجود المخابرات فحسب، ولكنها تعبّر أيضاً عن الطبيعة الحساسة والمحرمة لأجهزة المخابرات في سورية، فالحديث العلني عنها بالتأكيد ليس مسموحاً، لكنه تحدَّثَ عنها كما تحدَّثَ في أمور أخرى ذات طبيعة مُحرّمة كالطائفية. ربما كان هذا عائداً إلى تصور أمجد عن ذاته، فهو قبل كل شيء أوضحَ بشدة أنه لا يرى نفسه إلا «ابن المؤسسة». وهذا من ناحية يعني أنه منخرطٌ تماماً في ثقافة وتقاليد المخابرات العسكرية، وأن ولاءه لذلك الجهاز يأتي أولاً وقبل كل شيء ويعلو على أي ولاءٍ آخر طائفي أو مناطقي. ومن ناحية أخرى، فقد كان حرفياً ابناً للمؤسسة حيث خدم والده كصف ضابط لعقود.
ألقت المجزرة بظلّها على المقابلات كموضوع آخر تجنّبنا الحديث عنه، وبدورنا لم نلمّح في أي وقت أننا رأينا مقاطع الفيديو وأننا على درايةٍ بجرائمه. ومن خلال شرحه كيف يرى أسباب وسياقات النزاع في سورية، بدأ يتضح أنه ازداد تشدّداً بعد مقتل شقيقه الأصغر الذي قضى أثناء أدائه خدمته العسكرية في الجيش بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2013، الأمر الذي كان شديد التأثير على أمجد.
أصبح أمجد عاطفياً عندما ذكر هذه النقطة في المقابلة، وبدأ يعبث بولاعة سجائره بتشنج، وتمتم:
« لقد انتقمت، أنا لا أكذب عليكِ. لقد انتقمت، لقد قتلت. لقد قتلت كثيراً، قتلت كثيراً ولا أعرف عدد الأشخاص الذين قتلتهم» 7
وعندما واجهناه بجزءٍ من الفيديو بعد بضعة شهو،ر وعلم أننا على اطلاعٍ عليه، أنكر بدايةً أن يكون هو الشخص نفسه الذي يظهر في مقطع الفيديو، ثم قال إنه كان يقوم باعتقال شخصٍ ما فقط. ولكن في نهاية المطاف استقرّ على تبرير أنها مقتضيات وظيفته، وعبر عن مكنوناته: «أنا فخور باللي عملتو».
لماذا وافق أمجد على التحدث إلينا مطولاً؟ ربما كانت الأسباب مزيجاً من الفضول والعزلة والغضب. فمع انتهاء الحرب بانتصارٍ باهت واقتصادٍ وطني متهالك، مضى مجرمو نظام الأسد في حياتهم بصمتٍ مع ذكرياتهم، يشربون العرق ويدخنون السجائر. أما بالنسبة لأمجد، فكان قد اختبر أيضاً تغييراتٍ في عمله أثارت امتعاضه، حيث أُنهيَ تكليفه بقيادة العمليات في التضامن واليرموك، ونُقل لممارسة وظيفةٍ مكتبية مملّة في الفرع. قد تكون الأسباب السابقة مجتمعةً هي ما دفعت أمجد للاعتراف بارتكابه مجزرة التضامن؛ ربما لا تعرف زوجته وأولاده عن هذا الماضي الأسود أي شيء، أو ربما لم يسأله عنه أحدٌ غيرنا قط.
المخابرات والشبيحة: شبكة القتل المتداخلة
تشير كلمة «مخابرات» في العالم العربي عموماً إلى وكالات الاستخبارات أو الشرطة السرية. يكمن تحت مظلة هذه الكلمة الاصطلاحية مجموعةٌ من الممارسات التي تعبّر عن سلطات ومناطق سيطرة متداخلة جزئياً ومتنافسة غالباً، تقوم أحياناً بالتجسس على بعضها والعمل ضد بعضها بينما تحافظ على الاستقرار الراهن للنظام. أسّس حافظ الأسد امبراطوريته المخابراتية منذ السبعينات اعتماداً على أربع وكالاتٍ استخباراتية: المخابرات العامة أو أمن الدولة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية، يتبع لهذه الأجهزة فروعٌ ازدادت قوتها بشكل ملحوظ بحيث بدأت تشكل في حد ذاتها فاعلاً مهماً مستقلاً نسبياً.
ما يميز الاستخبارات السورية عن مثيلاتها حول العالم بشكل أساسي هو صلاحياتها الواسعة لاستخدام العنف ضد المواطنين السوريين. فالأجهزة السورية تستطيع التنصت والتجسس على المواطنين، كما بمقدورها تهديدهم وابتزازهم، وأيضا اعتقالهم وسجنهم غالباً دون مذكرة أو أي اعتبار لسلطة القانون. تتسم سجون المخابرات السورية بالتعذيب الوحشي الممنهج واسع النطاق الذي ينفّذُه جلادون محترفون، ويمكن للمرء الادعاء أن السجن والتعذيب يُعرِّفان النظام السوري. 8
لا تقل قدرة المخابرات السورية على المراوغة عن سلطتها، فهي الفاعل الأكثر قوةً في النزاع السوري. مع هذا فهي متعذرةٌ على البحث والدراسة، وسيكون السير في دمشق وطرح أسئلة عن هيكلية المخابرات وأفعالها وتأثيرها مهمةً انتحارية (إلا إذا كان النظام يثق بالباحث). يعمل موظفو المخابرات مستخدمين أسماء حركية أو ألقاب عامة مثل «أبو حيدر» أو «أبو علي» أو «أبو جعفر»، ويمنع منعاً باتاً التدلال عليهم. تهدف هذه الممارسة المتعمّدة للمخابرات السورية إلى الحفاظ على السرية وإثارة الخوف في المجتمع، وهذا كفيلٌ بخلق أساطير مبالغ فيها عن رجال المخابرات وعن شخصياتهم وقُدراتهم. المختلف في الفيديو الذي لدينا أن الجناة يظهرون بشكلٍ صارخٍ بينما يبقى الضحايا مجهولين. يختلف ذلك جذرياً عن معظم فيديوهات الإعدام التي كانت تنشرها داعش، حيث يخفي القتلة فيها وجوههم خلف أقنعة، بينما يحرصون على إظهار وجوه ضحاياهم بوضوح.
يُعتبر فرع المنطقة من أقوى أفرع الاستخبارات العسكرية في سورية، وهو الفرع المسؤول عن محافظة دمشق وريفها. ترأسه في الثمانينات نزار الحلو (1942-2016)، ولكنه أُقيل بعد هروب مجموعةٍ من المعتقلين الإسلاميين، ليستلم رئاسة الفرع نائبه هشام الاختيار (1941-2012) الذي الاختيار في منصبه حتى العام 2001. أدار الفرع بين العامين 2005 و2012 رئيس قسم التجسس المخضرم رستم غزالة (1953-2015)، من بعده تسلّم عماد عيسى، ثم شفيق مصّة الذي كان رئيس الفرع المسؤول وقت ارتكاب المجزرة عام 2013.
يرأس العميد كمال الحسن الفرع 227 أثناء كتابة هذه الكلمات، ومقرّه الرئيسي عبارة عن مبنى شاحب على شكل حرف W في مجمع المخابرات الواقع بين جامعة دمشق وساحة الأمويين مقابل وزارة التعليم العالي.
كانت قائمة أصدقاء أمجد يوسف على فيسبوك أشبه بمعرض للقتلة، ومن بين أصدقائه وجدنا أحد زملاء أمجد في المخابرات «جمال خ.»، وهو من الطائفة السنية من حي القدم، يخفي بعناية شخصيةً لا ترحم خلف قناع أبوي صاخب ومرح وابتسامة مريضة، ويعلو وجهه شعرٌ رمادي. لهذه الشخصية قدرة كبيرة على خداع أي شخص. فعلى سبيل المثال، ظهر في تقرير لشبكة سي إن إن بتاريخ 3 كانون الأول (ديسمبر) 2013 على أنه القائد العسكري «أبو أكثم» الذي يُري المراسل فريدريك بليتغن حي السبينة الواقع جنوب حي التضامن مباشرةً بوصفه القائد الميداني المسؤول عن المنطقة. قَبِلَ «جمال خ.» طلب الصداقة الذي أرسلناه، وفي واحدةٍ من المقابلتين اللتين أجريناهما معه بعد أن وثِق بـ«آنّا» قال: «سأخبرك شيئاً لا يجدر بي أخبارك إياه: أنا رئيس أمجد يوسف»، وقد أصرّ جمال على معرفة من وصل آنّا بـ أمجد يوسف، واصفاً الأخير بأنه: «بطل، أخ الشهيد، وبالتأكيد ليس رأساً صغيراً». وأخذت المحادثة انعطافة حادة عندما سألته آنّا عن الانتهاكات المزعومة:
آنّا: «حدثتني منذ فترة عن إصلاح المعتقلين في السجون، ولكنّ وسائل الاعلام تقول إن النظام السوري قتل المعتقلين في سجونه وارتكب مجازر بحقهم؟»
جمال خ: «جوابي بسيطٌ جداً. لماذا آخذهُ إلى السجن وأقتله ثم أُتّهم بقتله؟ أنا أفضّل قتله على خط الجبهة وينتهي الأمر، فقد مات في معركة. إذا لم تكوني في مرمى نيراني ولكنك عدوتي وتدمرين بلدي، لماذا آخذك إلى السجن وأقتلك فيه ثم أتهم بقتلك؟ يطرح هذا السؤال كثيراً، ولكنه سؤال غبي. إن كان بمقدوري قتل شخصٍ ما في الشارع دون أن يراني أحد فلماذا أجلبه إلى سجني وأعطيه رقماً وغذاءً وماءً وهو عبءٌ على الدولة؟ هل تعلمين أنهم يأكلون ما نأكل؟ إنهم يأكلون من أكلنا. لماذا أجلبه ليأكل ويشرب من أكلي وشربي ويكلّف الدولة؟ وبعدها يتهموني به. هل هناك أغبى من هذا؟… عندما أقوم باعتقال عشرة أو خمس عشرة رجلاً مسلحاً فسيحتاجون إلى ثلاثين أو أربعين جندياً لمرافقتهم. لماذا المشاكل في حين إني قادرٌ على قتلهم في الشارع والراحة؟ لماذا أقتلهم في السجن؟ أنا أفضّل قتلهم في أماكنهم والانتهاء من الأمر» 9
والآن وبعد أن كشفنا دائرة المخابرات، ماذا عن القاتل الثاني الذي كان يرتدي بزّةً عسكريةً رمادية؟ كانت ذراع أمجد اليمنى في فيديو المجزرة هو نجيب الحلبي، والمعروف أيضاً بلقب «أبو وليم». عرفناه إذ وجدناه وقد تمت الإشارة إليه في منشورٍ على فيسبوك في صفحة «شهداء التضامن». نجيب ابنُ عائلةٍ درزية نازحة من الجولان، ولكنه ولد وترعرع في حي التضامن. وعلى عكس باقي سكان الحي الفقراء، كانت حالة نجيب المادية معقولةً وكان يدير ملهىً في منطقة باب شرقي قبل اندلاع النزاع. أنشأ في عام 2011 أول مجموعةٍ من الشبيحة في التضامن، متخذاً لها مركزاً على خط الجبهة بجوار جامع عثمان، الأمر الذي جعل منه بطلاً في نظر الموالين لنظام الأسد. خِبرتُه في حفر الأنفاق والخنادق كانت سبباً لاستدعائه للإشراف وتقديم المشورة أثناء القيام بهذه الأعمال على الجبهة أو عند ارتكاب المجازر.
كان نجيب في فيديوهات المجزرة يقف على حافّة القبر الجماعي، يدخن سيجارةً ويبتسم للكاميرا صانعاً علامة النصر بيده. لم يكن يُظهِر أي ضيقٍ على الإطلاق بينما يتم إعدام جيرانه الذين أمضى حياته بينهم، ويرمون في الحفرة. ما عرفناه عن نجيب أنه كان متواضعاً وذكياً، مستمعاً جيداً ومحبوباً من الجميع. وكأنه لم يُظهِر أبداً كراهيته وجانبه المظلم لأحد.
نجيب أثناء المجزرة
«لا يمكنك توقّع أنه سيفعل ذلك. لقد صُدِمتُ عندما رأيت الفيديو» يقول أحد الأشخاص الذي كان يعرفه. مع هذا فقد كان لنجيب أعداء. مات نجيب أثناء حفر نفق على الجبهة في العام 2015. ولا يزال سبب موته مثارَ جدلٍ حتى هذه اللحظة، فهناك من يعتقد أنه كان اغتيالاً دبّره له خصومه، وهناك من يلقي اللوم في موته على المعارضة.
صُمّمتْ مجموعات الشبيحة منذ إطلاقها لتكون قوةً ميليشياويةً فضفاضة، وبِنيّةٍ مُسبقة أن يستحيل تقفّي أثرها بحيث يتم ربطها مع قوات النظام الرسمية، وبهذه الطريقة يستطيع النظام (وقد قام بذلك في مناسباتٍ عدة) المحاججة أن مرتكبي العنف كانوا مجموعةً من المتطوعين المدنيين الذين يعملون خارج سيطرته. أدار فادي صقر (اسمه الحقيقي: فادي أحمد) المقرب من القصر الجمهوري هذه الميليشيات في دمشق. فادي كان بلا ذقن، يدخن بشراهة، أنهى دراسته الثانوية فقط، تفضح الهالات السوداء تحت عيونه قلة نومٍ مزمنة. ومع أنه ينحدر من أسرة تملك بعض الحظوة لدى النظام (كان والده ضابط مخابراتٍ سابق) إلا أنه سُجن بتهم فساد قبل اندلاع الاحتجاجات، وعلاقات الوالد مع النظام لم تفلح في إنقاذ ابنه. ويقال إن فادي قتلَ أحد زملائه في السجن قبل أن يحصل على عفوٍ رئاسي خاص بسبب الحاجة لخبراته القمعية مع تزايد زخم انتفاضة 2011. لم يكتفِ فادي بتأسيس مجموعات الشبيحة، بل شوهد بذاته يهاجم المتظاهرين بواسطة سكين. وسرعان ما أصبح وسيطاً مرموقاً للنظام ظهر علناً في أكثر من مرة برفقة بشار الأسد شخصياً. استفرد فادي صقر بالسلطة وأثرى نفسه لدرجة بات يحتقره موالو الأسد أنفسهم. فأمجد على سبيل المثال لم يعبّر إلا عن ازدراءٍ عميقٍ تجاهه.
يأتي بين نجيب الحلبي والعقل المدبر فادي صقر في الترتيب الهرمي للمجموعة قائد الشبيحة في التضامن، وهو رجل خمسيني، متهم بالكثير من جرائم الاغتصاب، 10
ذو شاربين رفيعين، نحيف ومفزع يعرف بلقب أبو منتجب واسمه «صالح ر.». قاد أبو منتجب مرحلةً من الرعب في التضامن، أطلق عليه زملاؤه أثناءه لقب «هتلر سورية».
قد يستخدم نجيب كلمة «معلم» لمخاطبة رئيسه المباشر أبو منتجب، ولكن يُحتمل أيضاً أن يستخدم الكلمة نفسها عندما يخاطب -أثناء اجتماعٍ ما- رئيس أركان قوات الدفاع الوطني في القصر اللواء بسام مرهج الحسن. يصعب تمييز بسام الحسن فائق السلطة، والملقب بـ«الخال»، عن أي شخص عادي، لكن لا يجب السماح للمظاهر أن تخدعنا، إذ إن «الخال» قادرٌ على تجاوز أي قرار بناءً على علاقة مقربة جداً تجمعه مع بشار الأسد.
يشرح بحثنا ومقاطع فيديو المجزرة بشكلٍ مكثف وقاطع علاقة التعاون والتواطؤ بين الشبيحة وأعلى مستويات الأجهزة المخابراتية.
تطهير الريف الجنوبي
تركّزَ النقاش العام خلال سنوات الحرب حول الاشتباكات والقصف النظام الجوي العنيف على مناطق سيطرة المعارضة. لكن بالمقابل بقيت مناطق سيطرة النظام على الجهة الأخرى من خط الاشتباك منسية. في حين أظهر فيديو التضامن، ومقابلاتنا مع جناة الحرب، وشهادات الناجين، أن ما حدث في التضامن قد ارتقى لعملية تطهير وحشية. فعندما تعمّقنا في البحث، أدركنا أن المجزرة كانت جزءاً من عملية موسعة ارتكبها النظام للتدمير والتطهير في أحياء دمشق الجنوبية. ولم تقتصر عملية الإبادة على المستوى المحلي في هذه المنطقة على نمط المجازر هذا، بل توسعت لتشمل على الأقل أربعة أنماط من العنف: القتل الجماعي الممنهج، والسجون، والاعتداءات الجنسية، والاستغلال الاقتصادي.
الفيديوهات التي بين أيدينا هي نموذج مصغّر عن عمليات القتل المُمنهجة والصامتة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة النظام. عندما تسلّحت المعارضة وسيطرت على جزءٍ من التضامن في الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بدأ النظام عمليةً متكاملةً من العزل والسيطرة. وأعطى الفرع 227 لمن سَمحَ لهم بالبقاء في الحي أذوناتٍ أمنية عن طريق قادة الدفاع الوطني المسيطرين على الأحياء. وكانت هذه الأذونات مطلوبةً لأجل أي نوع من النشاط، سواء كان عناية طبية مستعجلة أو زيارة صديق. كما نشر الفرع 277 بطاقاتٍ خاصة للمقيمين في الحي، وكانت على نوعين: الصفراء للمقيمين في حي دفّ الشوك، وأما الزرقاء للمقيمين في حي التضامن. واحتوت هذه البطاقات على معلومات عن حاملها: اسمه وعنوانه وأعضاء عائلته ومكان الولادة، وغيرها. وبذلك يكون الفرع قد أسس لنظام مراقبة وسيطرة موسع، وجمعَ معلوماتٍ مفصلة ودقيقة حول المقيمين في الحي.
لقد تم أخذ الضحايا الأوائل في المجزرة من منازلهم أو الشوارع في التضامن سيراً على الأقدام، إلى أماكن قريبة من مقار إقامتهم، حيث قتلوا وبقيت جثثهم في مكان تنفيذ المجزرة بحيث يمكن التعرف عليهم. وقد أظهرت فيديوهات ما بعد القتل أنه قد تم إطلاق النار على الضحايا عن قرب. هؤلاء الضحايا لجرائم النظام قد تم تجاهلهم، واستُخدمت هذه الفيديوهات في حرب السرديات بين المعارضة والنظام.
بعد تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، كان الضحايا يُؤخذون إلى مواقع محددة للإعدام، إما مشياً على الأقدام أو بالحافلات (السرفيس). ثم يُطلق النار عليهم واحداً تلو الآخر من الخلف، وتُحرق جثثهم حتى تصبح رماداً. وقد ظهرت هذه الطرق في القتل نتيجة حاجة جناة الحرب إلى طمس جرائمهم، والتخلّص من جثث الضحايا المكدسة في الشوارع. وعلى إثر ذلك، أسس كل أمير حرب موقعه الخاص للقتل. أدار أمجد واحداً، ولكن تفيد العديد من الشهادات التي أُخذت من الحي بأنّ شخصاً مثل «إبراهيم ح.» المعروف باسم «أبو علي حكمت»، وهو قائد في الدفاع الوطني وعضو سابق في سرايا الدفاع، كان يمتلك مقبرته البدائية لحرق جثث الضحايا الذين اعتقلهم من على الحواجز أو من مستشفى المجتهد. حتى إن جنوده يتفاخرون حول قدراته المضبوطة في قتل الناس وتدمير الدلائل، مدعين أن مجموعته قتلت أكثر من ثلاثين ألف مدني بين العامين 2012 و2015. هناك مبالغة على الأغلب في هذا الادعاء، ولكنه يعكس حجم العنف الممنهج في التضامن كما تصفه شهادة أحد المقيمين في الحي: «كنا نشم رائحة حديد واخزة نتيجة حرق الجثث كل يوم».
أما النمط الثاني للعنف في التضامن فهو السجون. تحوّلَ التضامن مع نهاية العام 2012 إلى سجن كبير بحجم الحي، مع تواجد ما يزيد على ستين حاجز وموقع أمني. حيث ازدادت حواجز الأمن العسكري – الفرع 227 والدفاع الوطني، وتمركزت حول مداخل الحارات في الجزء من الحي الممتد بين شارع الجلاء وخط المواجهات، والذي لا تزيد مساحته عن كيلومترٍ مربع واحد. وبنى قادة الدفاع الوطني جدران قسّمت الحي إلى خمس عشرة منطقة أمنية، ووثّقوا وسجلوا المدنيين المقيمين هناك. ما جعل من هذه المناطق غيتوهات خاصة تخضع لسيطرة وقواعد إدارة كل منهم. بما في ذلك السيطرة على أملاك المدنيين من منازل ومحال وتحويلها إلى سجون سرّية، تُستخدم لاحتجاز المدنيين وتعذيبهم. حتى إن نائب مدير مكتب المعلومات للدفاع الوطني، وصف التضامن بـ«مثلث برمودا» لأن كل من يدخل إليه يختفي. وقد أضاءت الفيديوهات والمقابلات التي أجريناها على حملة اعتقال واسعة في التضامن: أظهرت ثلاث من الفيديوهات تعذيباً شديداً لضحايا مدنيين في منازل خاصة، من ضرب وجلد وحرق وصعق كهربائي وتعذيب نفسي. كما مارس جناة الحرب، بمن فيهم أمجد يوسف ونجيب الحلبي، تعذيباً قاسياً وتجريبياً بغرض الاستمتاع بمعاناة الضحايا. وتشير جميع المعطيات بأن اللواء بسام الحسن كان على علم بهذه السجون، كما أشرف عليها وشجّعَ الجناة.
النمط الثالث للعنف في التضامن هو العنف الجنسي الذي كان سياسةً ممنهجة. حيث أخبرتنا إحدى الناجيات التي أجرينا معها مقابلةً شخصيةً أنها ذهبت إلى مقر الفرع 227 في شارع دعبول لتسأل عن مصير أحد أقربائها، وكان أمجد يوسف يجلس على كرسيه خلف المكتب في ضوء الغرفة الخافت ويدخن السجائر بينما كانت تسمع أصوات التعذيب من الغرفة المجاورة. أصغى أمجد يوسف لها بتمعّن، ووعدها بأن يطلق سراح قريبها بشرط: «إما أن تمارسي معي الجنس أو عليك نسيانه». ومنذ ذلك اليوم اغتصب أمجد هذه المرأة. ولم تكن هي الضحية الوحيدة، كان هناك أيضاً ضحايا كثيرات من أقربائها وجيرانها، وحتى أزواجهنّ كانوا عرضةً للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل المخابرات والشبيحة. كما تسبّب خطف الشبيحة الممنهج للرجال في الحي بانتشار جوٍّ من الخوف، وعزّزَ من ذلك الوضعُ الهشُ الذي تخضع له هؤلاء النسوة، مما أجبرهنَّ على مفاوضة الجناة لأجل النجاة، والموافقة بدون رغبة على علاقات جنسية معهم، أو بمعنىً آخر على عبودية جنسية. أما الرجال في الحي فقد اختبروا نوعاً مماثلاً من العنف الجنسي خلال فترات السجن والتعذيب. كان الرجال يُعتَقلون بسبب الاشتباه في علاقتهم بالمعارضة، ولكن ذلك كان في أحيان كثيرة بغرض ابتزاز نساء العائلة.
النمط الرابع والأخير هو السخرة والاستغلال الاقتصادي. مع تصاعد الاشتباكات على خط النار في عام 2013، اعتقل المخابرات والشبيحة الرجالَ من الطائفة السنية من التضامن ودف الشوك ومناطق أخرى، واستخدموهم للسخرة في حفر الأنفاق وبناء الحواجز والجدران على خط الجبهة، مُعرَّضين لنيران فصائل المعارضة. وأما الذين نجوا من المعاناة والمناوشات، فقد أُطلقت عليهم النار وأُحرقت جثثهم. وكان للسخرة هدف عسكري واقتصادي أيضاً، فقد شكلت استثماراً مثمراً لتجار الحرب وقادة المخابرات. إذ كان على المدنيين دفع مبلغ مليوني ليرة سورية للحواجز العسكرية للهرب من السخرة.
من الأشكال الأخرى للعنف والقمع الاقتصادي في التضامن هو المصادرة غير المشروعة لأملاك المدنيين. ازدهر سوق العقارات بعد أن نزح المدنيون من مناطق سيطرة فصائل المعارضة إلى التضامن، فصادر قادة الشبيحة والمخابرات ملكيات القتلى والمُرحلين قسراً من الضحايا، وتم تأجير ملكياتهم في سوقٍ العقارات، تحت حجج كمساعدة أسر الشهداء من الجيش والنازحين أو للضرورات العسكرية. على سبيل المثال: صادر أمجد ورئيسه أكثر من ثلاثين عقاراً في التضامن، وما زالوا يستثمرونها حتى يومنا هذا.
الخاتمة: لماذا؟
شكَّلَ الضحايا عبئاً أخلاقياً وعاطفياً كبيراً علينا، لأننا كنا نعلم بمصيرهم في وقت كانت عائلاتهم تجهله. لقد كنا في مأزقٍ صعبٍ ومضاعف: أن نعرف، ولكن علينا الصمت وألا نخبر أي أحد. أردنا تحديد هوية الضحايا، لكن كان علينا أن نشارك الناس صورهم. كلما شاهدنا الفيديو أكثر، كنا نتساءل: هل نريد أن نرى لحظات أحبّائنا الأخيرة؟ كان معظم هؤلاء الضحايا منسيين ومُهمشين. ركَّزَ الإعلام العالمي على المعاناة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، بينما كان الأسد يعمل على التغطية على جرائمه وتعميم الصمت المميت على المجتمع السوري. أحدث ذلك خللاً حتى بالنسبة للضحايا، نتيجة قلة المعرفة عن آلامهم ومعاناتهم بسبب الخشية من «العار» والخوف والعجز والقمع المستمر. حتى أن إحدى الضحايا تساءلت بتعجّب: «هل كان ذلك اغتصاباً؟». وفي هذا السياق، أعطت مقابلات التاريخ الشفوي التي أجريناها الفرصة للناجين، ليس فقط لزيارة ذاكرتهم حول العنف، وإنما أيضاً للتأكيد على هوية الضحايا.
في النهاية نستطيع القول إن هذه الفيديوهات مميزةٌ بالمقارنة مع الفائض من فيديوهات العنف التي انتشرت من سوريا خلال النزاع، فقادة المخابرات الذي يكتبون التقارير لبشار الأسد ظهروا بوجوههم الواضحة يتعاونون مع الشبيحة في توثيق جرائمهم ضد مدنيين عزل. لكن لماذا فعلوا ذلك؟ من جهة، لا يمكن تحليل هذه الفيديوهات والنظر إلى مطلقي النار بمعزل عن السياق الموسَّع لحصانة أجهزة المخابرات السورية والميليشيات الخاضعة لسلطة بشار الأسد المباشرة. وإذا ما أخذنا مجرمي الحرب على محمل الجد، فقد اعتبروا هذه المجازر جزءاً من التضحية المنبثقة من الانتقام لرفاق السلاح، مثل هشام عيسى وعمار عباس، زميلَيّ أمجد اللذين قتلا في وقت سابق. قال أمجد في أحد الفيديوهات، وفي المقابلة، إنه انتقم لأخيه الأصغر نعيم، الذي مات في داريا. وفي تصوير الجناة لهذه الفيديوهات نوعٌ من التذكار، وأيضاً دليلٌ على أنهم قد أتمّوا عملهم، وكان لأفعالهم هذه تأثيرٌ عميقٌ ومدمّرٌ على التضامن.
أنصار شحود: حائزة على درجة الماجستير في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية من جامعة أمستردام ومعهد NIOD (المعهد الهولندي لدراسات الحرب والهولوكوست والابادة الجماعية). دراستها ركزت على دراسة عنف الدولة في سورية.
أور أوميت أونغر: بروفيسور في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة أمستردام ومعهد NIOD (المعهد الهولندي لدراسات الحرب والهولوكوست والابادة الجماعية). مؤلفاته ركزت على الإبادة الجماعية والعنف الجماعي في الشرق الأوسط.
1.Uğur Ümit Üngör, The Specter of Sectarian Violence in Syria, in: Newlines, 9 February 2022.
الذي ارتكب أعمالاً شنيعة على طول البلاد وعرضها، وفي الوقت ذاته هو موطن شخص مثل آصف الذي أمضي في زنازين المخابرات الجوية 12 عاماً.
2.Uğur Ümit Üngör, Shabbiha: Paramilitary groups, mass violence and social polarization in Homs, in: Violence, vol.1, no.1 (2020), 59-79.
3.بحسب مقابلات مع شهود عيان وضحايا، بالإضافة الى التحديد المبدئي لبعض الضحايا في الفيديوهات.
، إلا أن هناك مؤشرات تدل على أن هناك بعض الإسماعيليين بينهم استهدفوا نتيجة نشاطهم السياسي المعارض.
4.مقابلة مع أمجد عبر فيسبوك بتاريخ 22 آذار (مارس) 2021.
5.مقابلة مع أمجد عبر فيسبوك بتاريخ 26 آذار (مارس) 2021.
6.مقابلة مع أمجد عبر فيسبوك بتاريخ 10 حزيران (يونيو) 2021.
7.مقابلة مع أمجد عبر فيسبوك بتاريخ 10 حزيران (يونيو) 2021.
8.Uğur Ümit Üngör and Jaber Baker, De Syrische Goelag: De Gevangenissen van Assad, 1970-2020 (Amsterdam: Boom, 2022).
9.مقابلة مع جمال خ. عبر فيسبوك بتاريخ 23 آذار (مارس) 2021.
10.بناءً على مقابلات مع ضحايا مباشرين لـ«أبو منتجب» وشهادة زملاء له.
موقع الجمهورية
———————————-
مجزرة التضامن… داعشيو الأسد/ ناصر السهلي
لم تسجل العدسات مجازر فلسطين، إرهاباً وتهجيراً، بين إبريل/نيسان ومايو/أيار 1948، ولا قهقهة رجال العصابات الصهيونية الذين تحوّلوا إلى “رجال دولة”، ولا وجوه النساء والأطفال عند إبادتهم.
وعلى الرغم من بؤس عقود الشتات، بقيت المجازر محفورة ومتوارثة التفاصيل في ذاكرة أبناء نكبة فلسطين. الكشف أخيراً عن شريط يوثق فظائع مجزرة حي التضامن، المتشابك مع مخيمي اليرموك وفلسطين، جنوبي العاصمة السورية دمشق، يضيف بُعداً يصعب محوه من ذاكرة مجتمع السوريين، خصوصاً أن الجلاد هنا “ابن البلد” وليس محتلاً.
قد يجد البعض العربي صعوبة في فهم السمة المشتركة بين مذابح الصهيونية ونظام يدعي أنه “ممانع”. فالمذبحة المؤسسة لحكم آل الأسد ليست أقل فظاعة من التي أسست لدولة الاحتلال.
فما أقامه رجالات حافظ الأسد، من جسر الشغور وسجن تدمر وحماة (في الثمانينيات)، أسس لمشاهد سحل البشر ومذابح بانياس “البيضا” و”الحولة” وحمص وحلب وحماة، والرقص على جثث الضحايا في داريا والغوطة بعد 2011.
التفاخر بهز البنادق والهتاف “شبيحة للأبد… لعيونك يا أسد”، يتحول حين تضبطه العدسة إلى “مؤامرة”، و”فبركة الغرف السوداء”. جلادو الأسد، في لحظة الاعتقاد أن التقادم يجعلهم بمأمن، يختزلون مأسسة الجريمة، إذ قال أحدهم للباحثين في تفاصيل المجزرة: “لماذا آخذك إلى السجن وأقتلك فيه ثم اُتهم بقتلك؟”.
فـ”المؤسسة” التي ربت الجلادين هي نفسها التي توزع على الأهالي بطاقات هويات المختفين قسراً بعد ادعاء “موتهم بسكتة قلبية” في مسالخها.
ثمة رهط، بينهم عرب، يهتفون لقاتل شعبه بادعاء أنه “ممانع” للصهيونية، التي يستخدم نفس أدواتها البدائية في المذبحة. هؤلاء يضيقون، تحت سقف متلازمة استوكهولم، إذا ذكرهم الضحايا بالربط بين دير ياسين وكفر قاسم وبحر البقر وصبرا وشاتيلا وقانا ومثيلاتها من مذابح سورية.
فحي “التضامن” مثله مثل “اليرموك” و”الحجر الأسود”، فيه اجتمع بسطاء البلد، من كل مناطقهم، مع أشقائهم الفلسطينيين، وأضحوا على ذاكرة مشتركة عن المذابح الصهيونية ومذابح أبناء الأسد الأب وعمهم رفعت.
أفظع ما في المجزرة السورية المستمرة، بما فيها بالسلاح الكيميائي، أن بروباغندا مؤيدي جلادها يصنفون الضحايا، من أطفال ونساء ومراهقين، باعتبارهم “عملاء متآمرين”، بل أعاقوا “تحرير الجولان والقدس”. هل يتذكر هؤلاء متى انطلقت أفعال “داعش”؟
مشاهد حرق ضحايا “التضامن” تخبرنا أن داعشيي الأسد سبقوا رفاقهم في “داعش”، ولم يكونوا أقل إجراماً ممن أطلق لحاه في فروع الأسد الأمنية.
العربي الجديد
—————————

“التضامن” بين الجلادين!
بعد حصولهما، بالصدفة، على شرائط فيديو توثق مذابح جرت عام 2013 في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق قام باحثان أكاديميان متخصصان بقضايا الإبادة الجماعية بتقديم نتيجة عملهما الذي دام سنوات والذي يوثق لمقتل 288 ضحية، معظمهم من الشباب، بالإضافة لبعض الأطفال والنساء وكبار السن، ويتابعان، خصوصا، واحدة من تلك المذابح نفّذها شابان من عناصر الفرع 227 التابع للاستخبارات العسكرية للنظام السوري (المسؤول عن حيي التضامن ومخيم اليرموك)، ضد لاجئين سوريين وفلسطينيين نزحوا بعد غزو إسرائيل لمرتفعات الجولان عام 1967.
حسب التقرير الذي أنجزه الباحثان، فإن وسائل الإعلام الرسمية السورية كانت تشير إلى الحي المذكور بوصفه “سوريا المصغرة”، لكون سكانه من خلفيات طائفية وعرقية وسياسية ومناطقية متنوعة، وإذا اعتمدنا هذه الفكرة المقترحة فيمكن القول إن المصير الذي تعرّض له سكان هذا الحي هو تلخيص لمصير سوريا نفسها.
تأثر الحيّ بالمظاهرات ضد السلطة التي جرت عام 2011، ورد عليها النظام بإنشاء مجموعات مسلّحة لقمع الاحتجاجات، وبذلك انقسم سكان الحيّ إلى ضحايا وجلادين، وقام اثنان من عناصر فرع المنطقة المذكور آنفا بتجهيز حفرة مليئة بإطارات السيارات تم إلقاء 41 شخصا فيها بعد قتلهم بإطلاق النار (وذبح أحدهم) ثم حرقهم، ويشير التقرير إلى أن القاتلين كانا ينفذان القتل بشكل إجرائي، وأنهما كانا يقتلان النساء بوحشية وعدائية لا يبديانها بالدرجة نفسها تجاه الرجال، بشكل يدل على اعتيادهما على هذا الفعل، بل ويستمتعان بما يقومان، وأن ذلك تم في وضح النهار، بل وقاما أيضا بتصوير كل ما فعلاه، كدليل ربما يستحقان عليه جائزة أو تهنئة من رؤسائهما.
واحد من منفذي المذبحة كان من سكان حي التضامن نفسه، وحسب الشرائط المصورة فقد كان يقف على حافة المقبرة الجماعية ينظر إلى جثث من قتلهم وهو يدخن سيجارة ويبتسم للكاميرا رافعا “علامة النصر” محييا قائده الأعلى الذي سيرى الشريط من دون أي انزعاج من كونه يقوم بإعدام الجيران الذين جاء بهم سيرا على الأقدام من منازلهم القريبة والذين عاش بينهم ويقذفهم إلى الحفرة.
يكشف التحقيق أن الإبادة والاضطهاد الجماعي هي جزء من سياسة ممنهجة تتضمن العنف الجنسي حيث يستخدم الاغتصاب كعقاب وآلية إذلال للمجتمع الأهلي، وكذلك السخرة، حيث استغل السكان في حفر الأنفاق وبناء الحواجز والجدران، وصولا إلى القمع الاقتصادي عبر مصادرة أملاك المدنيين.
يتزامن الكشف عن تفاصيل هذه المذبحة مع مجازر أخرى تحصل حاليا، كما هو الحال في مذابح منطقة دارفور السودانية، ومذابح بوتشا الأوكرانية، ومذابح مالي التي يظهر أن مرتزقة فاغنر الروس، وربما عناصر من الجيش الفرنسي، مسؤولون عنها.
يتزامن ذلك أيضا مع الكشف عن تفاصيل جديدة عن مذبحة الطنطورة التي وقعت خلال حرب النكبة الفلسطينية، والتي أظهرت شهادات جديدة لجنود إسرائيليين أن عدد الضحايا يفوق المئتين.
في شهادة القاتل السوري للأكاديميين اللذين أجريا البحث، قال إنه لا يعرف عدد الأشخاص الذين قتلهم، وفي شهادة أحد الجنود الإسرائيليين ورد أمر شبيه حيث قال إنه “لا يعرف عدد الذين قتلهم من العرب”، وكما استخدم القاتل السوري بندقية رشاشة ومسدسا، فقد فعل ذلك أحد الجنود الإسرائيليين، كما استخدم أحد الضباط مسدسا كان يقتل به الفلسطيني تلو الآخر.
تحوّل مكان مذبحة الطنطورة إلى موقف سيارات لموقع استجمام إسرائيلي، وقُصف موقع مذبحة التضامن لإخفاء معالم القبر الجماعي، وتحوّل أحد منفذي المجزرة ملاكا لأكثر من ثلاثين عقارا تمت مصادرتها في الحي.
تظهر تشابهات الوقائع “تضامنا” بين الجلادين في مناهج سياساتهم، وقدرة فظيعة على اعتياد التوحّش وتحويل البشاعات إلى مصالح، وهو ما يظهر أيضا ضرورة تضامن الضحايا ضد الجلادين أينما كانوا.
القدس العربي
———————–
“لا أعرف عدد الأشخاص الذين قتلتهم”: أمجد يوسف، يروي مجزرة التضامن نيابة عن النظام السوري/ كارمن كريم
إنها مجزرة تستمر لحوالي 25 دقيقة، 25 دقيقة كافية لقتل 41 مدنياً ولا نعلم أن المجزرة انتهت إلا حين يسأل أحد الجناة: “في غيرو؟”، لكن في تلك اللحظة لم يكن هناك ضحية أخرى، كان الجميع في حفرة الموت الكبيرة.
بدا الفيديو كـ”لعبة” للوهلة الأولى، رجلٌ بلباسه العسكري وقبعة صيد وضعها على رأسه، يطلب من الضحايا الجري وهم معصوبو الأعين، ثم يطلق النار على بعضهم أثناء جريهم بينما يسقط آخرون في الحفرة المعدّة لتكون مقبرة جماعية ثم يطلق رفيقه النار عليهم. كأنها “لعبة”، تتهاوى الأجساد فوق الإطارات المعدّة لإشعالها لاحقاً. مجزرة التضامن، واحدةٌ من عشرات المجازر التي ارتكبها نظام الأسد وكان ضحاياها أوفر حظاً فلم يبقوا قيد النسيان.
مجندٌ يسرّب التسجيلات
الفيديو الذي نشرته صحيفة الغارديان بدا كإعلان لفيلم طويل من القتل والتنكيل، رافقه تقرير مطول عن حكاية، لن يكون تصديقها سهلاً لولا أن القاتل لم يتردد في إظهار وجهه. قصة بدأت مع صدفة جمعت مجنداً بفيديو صادم على كمبيوتر أحد قادته، حين طلب منه إصلاحه، لم يمنع الخوف ذلك المجند من القيام بخطوة أولى في طريق كشف جرائم النظام، فاحتفظ بالتسجيلات، في حركة متهورة كانت لتكلّفه حياته بكل بساطة.
بدأت الحكاية في العام 2019 حين وصلت التسجيلات إلى أور أوميت أونغر وهو متخصص هولندي وباحث في هذا النوع من الإبادات، وأنصار شحود وهي متخصصة في دراسة العنف في سوريا، إلا أن التسجيلات كانت صادمة حتى لأولئك الذين يبحثون منذ سنين في أعمال العنف والابادة الجماعية.
في وقتٍ تسعى دول عربية لتعويم نظام الأسد وإعادته إلى الساحة العربية والدولية يظهر فيديو مجزرة التضامن ليشير إلى القاتل من دون مواربة أو شكّ، تنظر عيون القاتل في الكاميرا بينما عيون الضحايا معصوبة، وأيديهم مُقيّدة، ينزلون من ميكروباص أبيض، الواحد تلو الآخر، ليلقوا مصيرهم، والضحايا هم مدنيون بحسب التقرير، ممن اعتقلوا في حي التضامن أو على الحواجز المحيطة به، ليتم نقلهم إلى موقع المجزرة وتصفيتهم.
الجريمة هنا أكثر قسوة وأشد وطأة، لأن القاتل لا يجعل الضحية تشك للحظة في مصيرها، الضحية تهرب لأنها تعتقد أنها ستنجو فالقاتل أخبرها بذلك وهي صدقته ولذلك سقطت في حفرة الموت الكبيرة، لم يكتف القاتل بجريمته بل سكب الوقود على الجثث وأشعلها، هل اعتقد أن النار تخفي الجرائم؟ وأن التراب لو انهال فوق الجثث لن تنبشه العدالة في يوم ما؟
لا تنتهي القصة بالتسجيلات. لا بد من الوصول إلى معلومات أدق حول المجرمين والجهات التي يتبعون لها، وكانت لدى أور وأنصار خطة إلى جانب بحثهم الحثيث عن المعلومات وهي خداع عناصر النظام عن طريق شخصية وهمية تدعى آنا، تأملوا الوصول من خلالها إلى القاتل. خلقت الباحثتان شخصية آنا منذ سنوات في سبيل دراسة عناصر النظام، وهي فتاة علوية من حمص تقيم في الخارج وتعمل على بحث أكاديمي عن النزاع السوري، وبدأت آنا نشاطها على فيسبوك بإضافة وملاحقة كل من يمكن أن ينتمي إلى منظومة الأسد على مدار سنتين، وفي كل الأحوال لن يشكّ عناصر النظام بفتاة علوية من الطبقة الوسطى قادمة من حمص تبدي حماسها لانتصارات النظام، وبعد بحث مضنٍ وفي يوم ما تمكنت أنصار من الوصول إلى القاتل الرئيسي في الفيديو، كان قد تغير بعض الشيء لكن ندبة فوق حاجبه الأيسر مكنتها من التأكد منه، وهكذا أرسلت إليه آنا أو أنصار طلب صداقة، وبدأت رحلة كسب ثقة المجرم أمجد يوسف سعياً للوصول إلى معلومات أو أي اعتراف حول مجزرة التضامن، ومع الوقت بدأت القصة تصبح أكثر وضوحاً وتمكنت آنا من الوصول إلى أسماء القتلة الآخرين في الفيديو.
الفيديو كاملا
أمجد يوسف مواليد 1986 برتبة ضباط في المخابرات العسكرية السورية، لا يعرفُ عدد ضحاياه حاله كحال جميع القتلة في هذه المنظومة، لكن الشيء الوحيد الذي كان متأكداً منه هو أنه قتلهم، هؤلاء الضحايا الواحد والأربعون هم جزء من سلسلة مجازر أكبر، فحسب التسجيلات، قتل عناصر النظام 288 ضحية.
من خلال أمجد وصلت أنصار إلى القاتل الآخر في الفيديو وكان نجيب الحلبي، إذ نعاه أمجد في إحدى المنشورات كصديق له وشهيد، في البداية كان أمجد حذراً في التعامل مع آنا، إلا أنه وبعد نهاية مكالمة الفيديو الأولى بدا أكثر راحة لشخصية آنا.
أما المقابلة الأقوى فكانت الثانية وكانت في وقت متأخر من الليل حيث كان أمجد يتمدد على أريكة مرتدياً قميصاً داخلياً وهو يشرب العرق ويدخن بشراهة، حيث بدأ يسرد تفاصيل عن حياته: ولد أمجد في قرية نبع الطيب العلوية في منطقة الغاب وسط غرب سوريا، وهو الابن الأكبر لعائلة مكونة من عشرة أطفال، التحق بمدرسة المخابرات العسكرية وكانت فرصته الحقيقية ليغير حياته، من دون أن يعيش مثل عائلته منهكاً من العمل في حقول التبغ، إلا أن هناك حقيقة بسيطة لم يلحظها أمجد أن العمل لصالح النظام هو سجن آخر “وبدلاً من أن يحرره العمل في المخابرات من واقعه، أدى ذلك إلى ترسيخه أكثر في المجتمع الموالي للنظام، وحوّله إلى «ابن المؤسسة». وخلافاً لطموحه أصبح الولد سرّ أبيه”. أستطاع أمجد النجاح في سلك الأمن السوري وبين عامي 2011 و2021 كان المسؤول عن أمن خطوط الجبهة في منطقتي التضامن واليرموك، إلا أن التغير المحوري كان بعد وفاة أخيه الأصغر عام 2013 وهو ما كان شديد التأثير عليه، يقول لآنا: “لقد انتقمت، أنا لا أكذب عليكِ. لقد انتقمت، لقد قتلت. لقد قتلت كثيراً، قتلت كثيراً ولا أعرف عدد الأشخاص الذين قتلتهم”، وبعد مواجهته بالتسجيلات أنكر أمجد أن يكون هو ذات الشخص، إلا أنه في النهاية قال: “أنا فخور باللي عملتو”، وهكذا اعترف القاتل بجريمته.
“لا تفكروا حتى بمعارضتنا”
هناك حقيقة بسيطة إلا أنها تشكل إلى حد كبير منهج نظام الأسد، يقول التقرير في نسخته العربية والمنشور على موقع “الجمهورية”: “لم يكن الضحايا من الثوار، بل كانوا مدنيين لم ينحازوا إلى أي طرف، وارتضوا لأنفسهم أن يبقوا في حماية الأسد. إلا أن غالبية أهالي التضامن رأت في قتلهم رسالة لكل سكان ذلك الحي: “لا تفكروا حتى بمعارضتنا””، ولهذا الغرض أعدّ العناصر الموقع بحيث يكون مناسباً لجريمتهم بل يبدون في التسجيل شديدي الراحة خلال قتلهم المدنيين، أحدهم يدخن ويرفع إشارة النصر في وجه الكاميرا.
مازال نظام الأسد قادراً على إدهاشنا وكأن لا حدود لأعماله الإجرامية فما زالت صور “قيصر” في البال حين اعتقدنا أنها أسوأ ما قد يفعله هذا النظام. يبدو أننا أخطأنا إذ يتحدث التقرير عن شهادات سكان من الحي تحدثوا عن رائحة واخزة تنتج عن حرق الجثث، ولا أعداد دقيقة للجثث التي أُحرِقتْ. إذاً لم يحدث الأمر لمرة واحدة بل كان جريمة مستمرة، وكان هناك منافسة بين مرتكبي المجازر، حول من يقتل أعداداً أكبر. يميل النظام السوري وعناصره إلى الاستمتاع بجرائمهم ولا يستطيعون في الحقيقة إخفاء ذلك، يقوم أمجد في الفيديو بالسخرية من الضحايا وإيهامهم بأنهم يمرون من منطقة يتمركز فيها قناص مردداً: “قناص يا عرصة”، دون أن يعرفوا أن أمامهم حفرة ليسقطوا فيها بالنهاية، لا يريد أمجد للضحايا سوى الموت حيث لا مهادنة ولن تنفع استجداءاتهم ولا حتى صرخات النساء، يظهر في التسجيل قتل ست نساء بالفعل، “فيما يبدي أمجد درجةً من نفاد الصبر لأن أحد الضحايا لم يَمت لا من الطلقة الأولى ولا من الثانية، وبعد الطلقة الثالثة يصرخ مخاطباً الضحية «موت يا عرصة، ما شبعت؟». حتى الأطفال لم ينجوا ففي فيديو آخر، تتحرك عدسة الكاميرا فوق أجساد مجموعة من الأطفال وسط غرفة مظلمة، يتحدث أمجد قائلاً: “أطفال كبار الممولين في ركن الدين، تضحية لروح الشهيد نعيم يوسف”، أمجد انتقم لأخيه على طريقة النظام باغتصاب النساء وارتكاب المجازر والافتخار بقتل الأطفال، هل حصل على انتقامه بالفعل؟
إنها مجزرة تستمر لحوالي 25 دقيقة، 25 دقيقة كافية لقتل 41 مدنياً ولا نعلم أن المجزرة انتهت إلا حين يسأل أحد الجناة: “في غيرو؟”، لكن في تلك اللحظة لم يكن هناك ضحية أخرى، كان الجميع في حفرة الموت الكبيرة.
درج
——————————
ماذا قال السوريون عن مجزرة التضامن؟
أثار تحقيق صحيفة الغارديان البريطانية عن مجزرة التضامن والفيديو الذي نشرته، ردود فعل واسعة لدى السوريين، وأعاد إلى ذاكرتهم مئات التسجيلات المصورة المسربة عندما كان عنصار النظام يتلذذون بتعذيب السوريين حتى الموت.
في 16 من نيسان (أبريل) من العام 2013 أعدم كل من أمجد يوسف ونجيب الحلبي، 41 شخصاً عبر الإلقاء بهم في حفرة وسط أحد الشوارع في حي التضامن، ومن ثم إطلاق الرصاص المباشر عليهم وإحراق جثثهم بإطارات السيارات.
وفي التقرير التالي ترجمة وتحرير موقع تلفزيون سوريا للتحقيق كاملاً:
المجرم أمجد يوسف وهو يغتال الضحايا في مجزرة التضامن – المصدر: غارديان
https://www.syria.tv/?utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion
وقالت صحيفة “الجمهورية
” في تحقيق لها إن هذا الفيديو الذي تم نشره هو واحد من 27 فيديو تم تسريبها، ويظهر فيها مقتل 288 مدنياً بينهم 7 نساء ومجموعة غير معروفة العدد من الأطفال، على يد يوسف والحلبي اللذين يعملان في فرع المنطقة التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، والمعروف أيضاً بالفرع 227.
ما السياق الذي ارتكبت فيه مجزرة التضامن؟
أوضح الصحفي السوري مطر إسماعيل في منشور على فيس بوك السياق الذي وقعت فيه مجزرة التضامن، حيث إنها ارتكبت خلال الفترة التي سادت فيها أجواء استعدادات الفصائل العسكرية للدخول إلى العاصمة دمشق وبدء معركة إسقاط النظام عسكريا.
وقعت المجزرة في الجزء الجنوبي الشرقي من التضامن، في منطقة كانت قريبة من خط التماس مع فصائل المعارضة في شارع دعبول- منطقة سليخة المدمرة، أي أن خط التماس هو جبهة قتال لا يوجد فيها سكان إطلاقا بعد تهجيرهم قبل عدة أشهر، والمنطقة التي نفذت فيها المجزرة ما زالت مستباحة لليوم، ويمنع الوصول إليها.
ويبعد موقع المجزرة عن حاجز مخيم اليرموك الفاصل بين المخيم وحي الميدان، تحديدا منطقة دوار البطيخة، قرابة 1 – 1.5 كم، وحينذاك كان الأهالي بعد سيطرة الجيش الحر على المخيم في كانون الأول/ديسمبر 2012، يضطرون للخروج بالمئات يوميا نحو دمشق لتأمين حاجياتهم بعد فرض حصار جزئي على المنطقة، ثم يعودون قبل المغرب، مع إغلاق الحاجز مساء من قبل النظام، ومنهم من كان يهرب من الحصار دون عودة.
عملية الخروج كانت خطيرة ومرعبة، حيث كانت تتخللها حالات قنص للمارة المضطرين إلى التوجه من ساحة الريجة نحو شارع اليرموك الرئيسي وصولا إلى الحاجز، مسافة قدرها نحو 400 – 600 متر، في أي سنتيمتر منها يمكن أن تسقط قتيلاً، كانت مكشوفة لقناصي النظام الذي كانوا يتسلّون في كثير من الأحيان باستهداف المدنيين مما أوقع عددا من القتلى.
ثم بعد وصول الأهالي إلى الحاجز يخضعون لعملية تفتيش دقيقة اشتدت بمرور الوقت، وهناك اختفى العشرات وربما المئات من المدنيين دون أن يعرف مصيرهم، وهناك في الغالب اختار المجرم أمجد اليوسف قائمة ضحاياه العشوائية، ليتسلى هو الآخر بهم في سبيل الانتقام والتشفّي من أبرياء عزّل.
وأضاف إسماعيل: “من المعلوم أن المنطقة المحيطة بحاجز قوات النظام كالثقب الأسود، فهي تمتد من منطقة بنايات القاعة، مسجد الماجد، مسجد البشير، وصولا للفرن الآلي بين الزاهرة والتضامن، هذه الخاصرة كانت مرتعا لأقذر شبيحة عرفتهم العاصمة، وهم شبيحة شارع نسرين، الذين انتسبوا لعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية أهمها “الدفاع الوطني”، وسُمّوا على اسم شارع نسرين في حي التضامن والذي تقطنه غالبية علوية”.
شكّل الشارع/الدويلة حالة رعب للمناطق المحيطة، واشتهر شبيحة شارع نسرين في قمع المظاهرات ثم في حملهم السلاح باكرا وتشكيل ميليشيات ارتكبت مئات المجازر بحق المدنيين، وأخذت طابعا طائفيا كونها تشكّلت في الغالب من أبناء طائفة واحدة، كان من بينهم المجرم أمجد اليوسف الضابط في فرع المنطقة 227 التابع لشعبة الأمن العسكري.
وأشار الصحفي السوري إلى أن تحقيق الغارديان أظهر بشكل واضح أن “المجرم أمجد قرر أن يختار عينة عشوائية من ضحايا مدنيين، تثبت أزياؤهم وصحتهم أنهم لربما قد اعتقلوا في اليوم نفسه أو خلال أيام قليلة فائتة، لا تظهر عليهم علامات خوف أو تحضّر للإعدام، لا يبدو أن هناك شكّ حقيقي في أنهم سيرمون بالرصاص بعد قليل، شباب ورجال ونساء، ملابسهم توحي بفقر الحال و”العادية”، بمعنى أن الضحية ممكن أن تكون أي مواطن سوري يخرج عبر الحاجز يوميا، أو وجد مصادفة في الشارع، دون أن يُسأل عن موقفه السياسي، وربما بعضهم موالون للنظام أصلا”.
مجازر غير معروفة حتى الآن
وقال الباحث السوري أحمد أبازيد: “إن أفظع ما تحكيه مجزرة التضامن هي المجازر التي لم تُعرف وربما لن نعرفها، عثر مجند على الفيديو صدفة وقام بتسريبه إلى أن انتشر اليوم، كم من مجزرة لم تصوّر، أو صوّرت ولم يعثر عليها أحد، أو رآها ولم يسربها، صدفة نادرة في عالم القمع الشامل ومصنع المذبحة حصلت في مجزرة التضامن، ولكنها نقطة ضوء في بحر العتمات المهول”.
وتابع في منشور له على فيس بوك: “لم تُعرف مجزرة التضامن في حينها، والخبر الوحيد عن الحي في ذلك اليوم (16-4-2013) كان وجود اشتباكات ككل يوم… حتى المجازر التي عرفناها لم نعرف إلا النزر اليسير من تفاصيلها، ولم يمكن أن نتصور تفاصيل لحظات الأهوال التي عاشها الضحايا بينما يُساقون إلى المذبحة، وكأنها ليست من هذا العالم”.
تطور غايات النظام في المذبحة السورية
وأوضح أبازيد أن النظام كان يقتل المتظاهرين بداية للترهيب، وكان يتم تشييعهم، لكن لاحقاً كان قناصة النظام يمنعون من يقترب من الجثث ويقتلونه، “كان يريد للجثث أن تُرى وتبقى أمام الناس”.
أما في العام 2012 فكان النظام يقتل المدنيين في المناطق المنتفضة لمعاقبتهم وترهيبهم بشكل جماعي، وظهر وقتها الذبح الطائفي ومداهمة المناطق وقتل عوائل بكاملها ثم الانسحاب، وتواترت وقتها حوادث قنص الأطفال والنساء في الشوارع، كان بعضها يكتشف فوراً، وبعضها يستمر اكتشافه بعد أيام وأسابيع لأن الجثث في مناطق الاشتباك، مجازر مثل حي الرفاعي وكرم الزيتون في حمص اكتشفت الجثث فيها على مدى أيام وأسابيع، وكانت تتفسخ أحياناً أو تؤكل من الحيوانات قبل اكتشافها، “وكان النظام يريد أن تُرى وتسمع أيضاً، رأينا وقتها التريمسة والقبير والحولة وداريا وعرطوز وعشرات المذابح”.
وأضاف الباحث السوري في منشوره: “في الجيل الثالث من المذبحة، كان القتل لأجل القتل والانتقام والتسلية، كان يتم إخفاء الجثث منذ بدايات الثورة، ولكنه لاحقاً أصبح أسلوباً ممنهجاً، المقابر الجماعية وحرق الجثث لإخفائها أصبح أكثر شيوعاً، في هذا الوقت حصلت مجزرة التضامن وجديدة الفضل والبيضا وبانياس، وبدأت تظهر القصص عن محارق الجثث الجماعية في السجون .. في الأجيال اللاحقة من المذبحة أصبح النظام وشبيحته يقتلون بكل الطرق بلا ملل، بالطيران والصواريخ والملغمات والسجون والإعدام على الحواجز، مجازر أمام الناس أو تحت الأرض، مجازر في البث المباشر، وأخرى لإشباع شهوات القتل في السر، عرفوا أن كل شيء مباح واستباحوا كل شيء.
ويستذكر مغني الراب الفلسطيني سلام ناصر ما تعرض له من تعذيب على يد نجيب الحلبي، في حي التضامن، وتعرضه للضرب، من قبل العديد من العناصر أحدهم “الحلبي”. وسلام ناصر غنائي ومغني راب ومنتج، أصله من حيفا، ولد سلام ناصر ونشأ في مخيم اليرموك بدمشق، ومع تصاعد العنف في سوريا طلب اللجوء في درامن بالنرويج، حيث أتقن بسرعة اللغة النرويجية في عام 2019، فاجأ سلام مشهد الراب عندما بدأ المشاركة في معارك الراب ضد مغني الراب النرويجيين، مما يثبت أن موهبته لم تقتصر على لغته الأم.
وتحدث مراسل تلفزيون العربي عدنان جان ابن حي التضامن عن ذكرياته في شارع المجزرة وعن المجازر الأولى قائلاً:
أنا ابن حي التضامن. ولدت وترعرعت داخل أحيائه العشوائية وفي ثنايا فقره اللعين. كان مكان المجزرة (بنايات دعبول) مرتعاً لنا ونحن صغار. هي كانت بساتين للذرة نختبأ بداخلها هرباً من المدرسة. يملك معظمها رجل اسمه محي الدين. لطالما ظل يلاحقنا ونحن نسرق ذراه حتى قبل موسم الحصاد.
— Adnan Can Ataytürkmen (@CanAtayturkmen) April 28, 2022
الجريمة اليومية.. تعذيب المعتقلين
قال الصحفي السوري رأفت الرفاعي في منشور على حسابه في فيس بوك: “أمجد يوسف وأمثاله في مسالخ الأسد – الفروع الأمنية- يرتكبون جرائم يومية ربما أكثر بشاعة من مذبحة التضامن الميدانية، هناك حيث تنعدم الكرامة الآدمية، ويُعذب المعتقل، جسديا ومعنويا، في موت بطيء يكون الموت برصاصة في الرأس أهون وأقل شراً”.
وقال الصحفي السوري بشر أحمد: “الجريمة ارتكبت في العام 2013 والفيديو متوافر لدى مراكز حقوقية منذ ثلاث سنوات على الأقل والإفراج عنه الآن فضيحة للمجتمع الدولي.. لدى المجتمع الدولي آلاف الأدلة على إجرام نظام الأسد لكنه لا يحرك ساكناً ما لم تستدعِ الحاجة السياسية”.
ما الذي أثبته التحقيق؟
وأشار المعارض السوري أسامة أبو زيد في منشور له على فيس بوك إلى أن تقرير الغارديان “يفنّد لمنكري مذبحة الشعب السوري كيف أن كل عنصر من عناصر جيش النظام ومخابراته هو مجرم بالأصل وأنه لا وجود لشيء يسمى الجيش العربي السوري أو مؤسسة الجيش والأمن التي يجب أن يحافظ عليها السوريون عند بحثهم عن العدالة الانتقالية”.
وأضاف: “يردّ التقرير على ما يطرحه العالم وكثير من السوريين وبعضهم من المحسوبين على الثورة حول الخطأ في اللجوء إلى السلاح خلال الثورة السورية .. أصحاب ذلك الطرح صارو مطالبين باستعمال مخيلتهم ليتصوروا أن فرداً من أفراد عائلتهم كان يساق إلى خندق الموت قبل أن يطلق عليه النار لتحرق جثته لاحقاً بالدواليب والنفايات”.
وتابع: “يجيب التقرير في تتبعه لسيرة المجرم الذاتية هو ورفاقه على جمع كبير من الحمقى والمعتوهين ممن يحملون الثورة السورية مسؤولية تطييف الصراع”.
ولفت أبو زيد إلى أن التقرير “يخرّب خطط المبعوث الأممي بيدرسون واللجنة الدستورية ومن خلفهم المعارضة الرسمية ويجبرهم على مواجهة مرآة الحقيقة في وقت يتم فيه السعي إلى اتفاق قد يجعل عشرات الآلاف من أشباه القتلة الذين فضحهم التقرير أبطالاً حاربوا الإرهاب ولهم دور أصيل في مستقبل سوريا”.
وختم بالقول: “تفوق التقرير وصداه على ماكينة إنتاج سينمائي وتلفزيوني ضخمة حاولت من خلال دراما سخيفة تزوير التاريخ، مؤكداً التقرير أن النظام من رأس هرمه حتى أصغر تفصيل في قاعه النجس متورطون في قتل السوريين بكل دم بارد”.
ونشر الناشط الإعلامي عز الدين العلي تفاصيل مطولة عن المجازر الطائفية المرتكبة في حي التضامن، وكيف عثرت مجموعات من الجيش الحر على الجثث المتفسخة والمتفحمة في الأبنية والأقبية والشوارع
لعبة الحبار السورية
وصف الصحفي السوري يوسف غريبي مجزرة التضامن والمجازر المماثلة التي ارتكبهتها قوات النظام بـ ” لعبة الحبار السورية”.
وقال في منشور على فيس بوك: “يموت السوريون بالمجان لإمتاع القتلة الذين يصورون مجازرهم لمتعة رؤسائهم أيضاً.. ويأتيك من يقول إن سوريا آمنة وصالحة للعيش”.
وقال الصحفي قتيبة ياسين: “مرة سمعت أشخاصا من حماة عم يحكوا إنن وجدوا كميات عظام بشرية بأحد شوارع حماة في أثناء الحفر لتمديدات الصرف الصحي وقالوا إنها لوحدة من مجازر حماة في الثمانينات. الحقيقة استغربت إنو ليش النظام ليعمل مقابر جماعية بالشوارع وهو قادر ياخدن وين ما بدو. بعد ما شفت فيديو مجزرة التضامن عرفت ليش”.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي فهد الموسى أن مجزرة التضامن تثبت أن المجرم أمجد يوسف هو جزء لا يتجزأ من منظومة إجرام النظام الأسدي وهذه المنظومة لديها تسلسل أوامر هرمي تبدأ من بشار الأسد وتنتهي بضابط المخابرات أمجد اليوسف وعناصر فرع المنطقة التابع لشعبة الأمن العسكري.
وأضاف: “في سورية ممنوع على أي ضابط مخابرات أو جيش أو شرطة أن يقوم بعمل فردي أو اجتهاد شخصي الكل يعمل ضمن منظومة هرمية تنتهي بتقرير يومي يقدم إلى القصر الجمهوري الذي يبارك هذه الأعمال ويشجع عليها ويمنح المجرمين أرقى الأوسمة على إجرامهم”.
تلفزيون سوريا
——————

الفيديو الكامل لـ مجزرة التضامن جنوبي دمشق
تداول ناشطون مقطعاً جديداً يُظهر تفاصيل كاملة عن مجزرة التضامن المروّعة التي ارتكبها عنصر في مخابرات النظام السوري جنوبي العاصمة دمشق.
والمقطع الذي نشرت صحيفة “غارديان” مقاطع متفرّقة منه، أمس الأربعاء، يُظهر تنفيذ عنصر من مخابرات النظام يدعى أمجد يوسف، عمليات إعدام جماعية بطريقة شنيعة لـ41 مدنياً في حي التضامن جنوبي دمشق.
ويبدو في المقطع المصوّر (مدته 6 دقائق و43 ثانية) أنّ عشرات المدنيين سيقوا وهم معصوبو العينين ومكبّلو اليدين إلى مذبحةٍ في حي التضامن، ارتكبها “يوسف” وهو ضابط مخابرات في فرع المنطقة (227) بدمشق، منتصف نيسان 2013.
تحذير: الفيديو مروّع وعنيف
الفيديو كاملا
وبشكل فظيع، كان “يوسف” يطلب من الضحايا المدنيين – واحداً تلو الآخر – الركض هرباً من قنّاص “غير موجود”، ليُطلق عليهم الرصاص وهم يركضون نحو حفرةٍ تكدّست فيها جثثهم، التي أُحرقت لاحقاً على وقع ضحكات “يوسف” ورفاقه.
وواصل الناشطون السوريون نشر العديد من صور أمجد اليوسف (مُرتكب المجزرة) ومَن ظهروا معه في مقطع الفيديو، الذي جاء دليلاً على كيفية تعاطي النظام السوري مع المتظاهرين السلميين، منذ بداية الثورة السورية، منتصف آذار 2011.
مجزرة التضامن
وكانت صحيفة “غارديان” البريطانية قد نشرت، أمس، تحقيقاً يتحدّث عن مجموعة من قوات النظام السوري أعدمت 41 مدنياً بينهم نساء وأطفال، في 16 نيسان 2013، ورمتهم في حفرة، قبل إضرام النيران في جثثهم.
وذكرت التحقيق، أنّ مقطع الفيديو عثر عليه عنصر في قوات النظام بعد إعطائه جهاز كمبيوتر محمول لإصلاحه، فسرّب العنصر الفيديو إلى الناشطة السورية أنصار شحود والبرفيسور أوغور أوميت أوغور من مركز الهولوكوست والإبادة في جامعة أمستردام الهولندية، واستمرا بالعمل لمدة 3 سنوات في متابعة القصة والعثور على الشخص (أمجد يوسف) الذي يظهر وهو يقتل المدنيين ويحرق جثثهم.
وبحسب تحقيق “غارديان”، فإن ما جرى في حي التضامن جريمة حرب، نفّذها أحد أشهر فروع الاستخبارات التابعة للنظام السوري (الفرع 227 أو فرع المنطقة)، وهو فرع تابع للمخابرات العسكرية.
المجرم أمجد يوسف وهو يغتال الضحايا في مجزرة التضامن – المصدر: غارديان
فيديو مجزرة التضامن المروعة.. كيف لاحق باحثان أحد مجرمي الحرب في سوريا؟
ووفق ناشطين من حي التضامن، فإنّ أمجد يوسف (مُرتكب المجزرة) كان مسؤولاً عن الحي، وارتكب العديد من الانتهاكات فيه خلال تلك الفترة، 2013، وكان اسمه دائماً يتردّد مع بعض العناصر التابعين لـ ميليشيا “الدفاع الوطني”، لكون شارع نسرين هو جزء من حي التضامن الذي ينحدر منه بعض عناصر تلك الميليشيا، التي كان يقودها (فادي صقر) المُشارك في المجزرة.
يشار إلى أنّ نظام الأسد وحلفاءه ارتكبوا، منذ 2011، آلاف المجازر التي أودت بحياة مئات آلاف السوريين بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن أنّ معتقلات النظام وسجونه ومباني أجهزته وفروعه الأمنية تغصّ بمئات آلاف المعتقلين، قضى عشرات الآلاف منهم “تحت التعذيب” بينهم قرابة 11 ألف معتقل حتى 2014 (أي خلال 3 سنوات) موثّقين بالصور التي سرّبها “قيصر”.
————-
تعليقاً على مجزرة التضامن.. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمحاسبة نظام الأسد
أكدت الولايات المتحدة الأميركية “التزامها بمحاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها بحق شعبهه”، وذلك رداً على التحقيق الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية وكشفت فيه عن مجزرة ارتكبها عناصر في قوات النظام في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق في 16 من نيسان من عام 2013.
ونقلت قناة “الحرة” الأميركية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، دون أن تكشف عن اسمه، قوله إن “النظام السوري مسؤول عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، إضافة إلى ااستمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل”.
وأوضح الدبلوماسي الأميركي أنه “من دون المساءلة لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للصراع”، مجدداً تأييد الولايات المتحدة لـ “الدور المهم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ونرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها والمرتكبة في سوريا”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على أن الوزارة “تثني على جهود أولئك الذين يعملون لتقديم الأسد ونظامه إلى العدالة، وغالباً ما يعرضون حياتهم للخطر”.
المجرم أمجد يوسف وهو يغتال الضحايا في مجزرة التضامن – المصدر: غارديان
فيديو مجزرة التضامن المروعة.. كيف لاحق باحثان أحد مجرمي الحرب في سوريا؟
ويظهر تحقيق “الغارديان” أن كلاً من أمجد يوسف ونجيب الحلبي أعدما 41 شخصاً عبر الإلقاء بهم في حفرة وسط أحد الشوارع في حي التضامن، ومن ثم إطلاق الرصاص المباشر عليهم وإحراق جثثهم بإطارات السيارات.
وقال موقع “الجمهورية” في تحقيق له إن هذا الفيديو الذي تم نشره هو واحد من 27 فيديو تم تسريبها، ويظهر فيها مقتل 288 مدنياً بينهم 7 نساء ومجموعة غير معروفة العدد من الأطفال، على يد يوسف والحلبي، اللذين يعملان في فرع المنطقة التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، والمعروف أيضاً بالفرع 227.
——————————
مجازر النظام السوري: جرائم حرب موثقة بلا محاسبة/ أمين العاصي
أعاد التحقيق الذي نشرته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية الأربعاء الماضي، وكشف تفاصيل عن مجزرة ارتكبها النظام السوري جنوب دمشق، إلى الواجهة الإعلامية فظائع أجهزة النظام الأمنية وقواته في محيط العاصمة، لتفريغه من سكانه، وإعادة هندسته ديموغرافياً، بما يحقق خطط هذا النظام بالبقاء في السلطة.
وكان لتحقيق “ذا غارديان”، ومقطع الفيديو الذي يوثق مقتل 41 مدنياً بطرق وحشية في حي التضامن جنوب دمشق في العام 2013، وقع الصدمة على عموم السوريين، الذين استذكروا المجازر التي ارتُكبت على مدى نحو 10 سنوات ولم تصل العدالة إلى مرتكبيها.
وقال المدير السابق للمجلس المحلي في حي التضامن بريف دمشق عادل قطف، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “هذه المجزرة ليست الأولى التي ارتُكبت في حي نسرين وحي التضامن، جنوب العاصمة دمشق، فهناك العديد من المجازر التي ارتُكبت في المنطقة نفسها”.
وكانت بلدات وأحياء قريبة من العاصمة مسرحاً لأكثر مجازر النظام وحشية منذ العام 2011، والتي وثقها بالأدلة ناشطون إعلاميون وحقوقيون، لكن المجتمع الدولي لم يتحرك حتى اللحظة لمحاسبة مرتكبيها.
مجزرة داريا
كانت مجزرة بلدة داريا، الملاصقة لدمشق من الجهة الجنوبية الغربية، من أولى المجازر التي ارتُكبت، وكان الهدف منها إحداث الصدمة في محيط العاصمة، ودفع السكان إلى الهجرة أو النزوح. كما كانت رسالة دامية لبقية المدن السورية الثائرة على النظام.
وذكر ناجون من هذه المجزرة، التي وقعت منتصف العام 2012، أن المئات من المدنيين قُتلوا على يد قوات النظام والأجهزة الأمنية والشبيحة “بدم بارد”، وعثر لاحقاً على جثث نساء وأطفال في منازل وأقبية البلدة وحولها، وفي المساجد، حيث جرى إعدام كثيرين منهم رمياً بالرصاص من مسافة قريبة جداً خلال مداهمات للمنازل.
وذكرت لجان التنسيق المحلية، في حينه، أن عدد القتلى في مجزرة داريا وصل إلى 440 قتيلاً، وهو أحد أعلى إحصاءات القتلى في يوم واحد منذ اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011. لكن المجلس المحلي للبلدة أكد أن عدد القتلى نحو 700 مدني، بينهم 522 موثقون بالاسم. وروى ناجون من هذه المجزرة فظائع ما جرى في البلدة، التي دُمّرت بعد ذلك بشكل شبه كامل وهُجر ما تبقّى من أهلها.
مجزرة جديدة الفضل
“حرقاً وذبحاً بالسكاكين” قُتل نحو 500 مدني في إبريل/نيسان من العام 2013، في بلدة جديدة الفضل التي يقطنها نازحون من الجولان السوري المحتل، وتقع إلى الغرب من دمشق.
ووفق ناجين، استمرت المذبحة، التي قامت بها أجهزة النظام الأمنية وقواته وشبيحته، عدة أيام، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، جلّهم من الأطفال والنساء، بينما أكدت لجان التنسيق المحلية في حينه مقتل 566 شخصاً في جديدة الفضل بريف دمشق، معظمهم أطفال ونساء، قتلوا حرقاً أو ذبحاً بالسكاكين.
مجزرة الكيميائي في غوطة دمشق
فجر 21 أغسطس/آب 2013، ارتكب النظام واحدة من أكثر مجازره وحشية منذ بدء الثورة وحتى اللحظة، حيث قتل بالغازات السامة أكثر من 1400 شخص في بلدات غوطة دمشق الشرقية، التي كانت خارج سيطرة النظام ومحاصرة من كل الاتجاهات.
وقالت مصادر في “الجيش السوري الحر”، في حينه، إن القصف بصواريخ محمّلة برؤوس كيميائية، جاء من مقر اللواء (155) في منطقة القلمون في ريف دمشق، باتجاه الغوطتين الغربية والشرقية للعاصمة دمشق. وظن السوريون أن أيام بشار الأسد في السلطة باتت معدودة، لأنه تجاوز الخط الأحمر الذي وضعته له إدارة الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما.
لكن روسيا سارعت إلى التحرك، وأبرمت بسرعة كبيرة صفقة مع واشنطن يسلّم بموجبها نظام الأسد كل سلاحه الكيميائي، مقابل تفادي الضربة المحتملة، لتطوى بذلك صفحة من أكثر المجازر وحشية في الشرق الأوسط.
ولم تكن مجزرة الكيميائي هي الوحيدة في الغوطة الشرقية لدمشق، إذ قُتل وأصيب آلاف المدنيين على مدى سنوات بقصف من طيران النظام، وصولاً إلى إبريل من العام 2018، حين ارتكب النظام مجزرة ثانية بغازات سامة في مدينة دوما، لإجبار أهالي المنطقة على النزوح إلى الشمال السوري.
ووفق مصادر محلية، قُتل نحو 70 مدنياً بقصف بغاز السارين، ما دفع فصائل المعارضة إلى توقيع اتفاق مع الجانب الروسي تهجر من خلاله عدد كبير من سكان المدينة. وسبقته اتفاقات مماثلة في بلدات أخرى في الغوطة. وبدا واضحاً أن النظام كان يهدف إلى تفريغ الغوطة من جل سكانها، وهو ما تحقق عبر الحصار والقصف المتواصل والمجازر.
“مجزرة علي الوحش”
في مطلع عام 2014، قتل وفُقد ما بين 1200 إلى 1500 سوري وفلسطيني، على أيدي جيش النظام السوري و”حزب الله” اللبناني ومليشيات عراقية، في مجزرة تُعرف باسم “حاجز علي الوحش” على الطريق الواصل بين بلدتي يلدا وحجيرة جنوب العاصمة دمشق.
وكانت أحياء جنوبية في دمشق تعرضت لحصار خانق في العام 2013، وهي الحجر الأسود، والتضامن، والعسالي، والقدم، إضافة إلى بلدات يلدا، وببيلا، وبيت سحم، ومخيم اليرموك الذي كان يضم لاجئين فلسطينيين.
وفي مطلع عام 2014، أعطى “حزب الله” والمليشيات الأمان للعائلات للخروج من الحصار عبر معبر حاجز علي الوحش، وهو ما دفع الكثيرين للخروج، لكنهم فوجئوا بعناصر هذه المليشيات يفصلون الشباب عن المسنين، والنساء والأطفال.
وروى شاهد عيان، لـ”العربي الجديد”، أن عناصر من المليشيات قتلوا واعتقلوا عدداً من الشبان، وفعلت الشيء نفسه قوات النظام، مشيراً إلى أن نحو 1500 شخص قُتلوا واعتُقلوا في ذاك اليوم. وأضاف: من بين المفقودين ابني الذي كان عمره 15 عاماً. لم أعرف عنه شيئاً منذ ذلك اليوم. لدي أمل أنه لا يزال حياً في معتقل ما لدى النظام أو المليشيات.
مجازر النظام السوري بلا محاسبة
وفي السياق، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 49 مجزرة “تحمل صبغة طائفية” قامت بها قوات النظام في عموم سورية منذ العام 2011 وحتى العام 2015، قُتل فيها 3074 شخصاً، منها 5 مجازر في ريف دمشق، قُتل فيها 686 شخصاً، بينهم 113 امرأة و120 طفلاً.
وقال مدير الشبكة فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، إن النظام “ارتكب عشرات المجازر في ريف دمشق منذ عام 2011″، مشيراً إلى أن عدداً منها “يحمل صبغة طائفية، بما فيها المجزرة التي كُشف عنها الأربعاء (الماضي) في حي التضامن”.
وأضاف: “هذه الجرائم تفضح حقيقة هذا النظام وبشاعته وانحطاطه، وممارساته التي تعود إلى العهود المظلمة، ومن ثم لا يوجد أي شكل من أشكال التعايش معه على الإطلاق”.
وأشار إلى أن ملف الانتهاكات في سورية “قُدّم إلى المدعين العامين في فرنسا وهولندا وألمانيا”، مضيفاً: “التحقيق الذي نشرته صحيفة ذا غارديان يحمل كمّاً كبيراً من الأدلة، خصوصاً لجهة الكشف عن الجهاز الأمني المسؤول والأشخاص الذين قاموا بالمجزرة، ومن ثم يمكن قبوله في المحاكم الأوروبية”.
لكن عبد الغني رأى أن “الحراك السياسي السريع من قبل المعارضة السورية يجب أن يركز على وحشية هذا النظام بقواته البربرية وأجهزته الأمنية المتوحشة. بشار الأسد أشد توحشاً من أجهزته”.
من جهته، قال نقيب “المحامين السوريين الأحرار” غزوان قرنفل، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “السياق العام للأحداث لا يشي بتبدل المواقف الدولية وآليات التعاطي مع الملف السوري”، مضيفاً: “لا أعتقد أن مواقف جديدة ستتخذ باتجاه ملف المساءلة”.
وتابع: بعد أسبوع فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه بصدد فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا. وأضاف: بينما في سورية، وعلى الرغم من أطنان الوثائق والتوثيقات المودعة لدى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وعلى الرغم من صور وشهادة قيصر، وعلى الرغم من شهادة حفار القبور، لم يُتخذ أي إجراء تجاه النظام، وتم الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية التي تخرقها أولاً هيئات الأمم المتحدة العاملة بدمشق.
ورأى قرنفل أنه “مطلوب من السوريين المعارضين، أشخاصاً وهيئات، إعلان موقف رافض لمسار تسوية يفضي لشراكة في الحكم مع سلطة أبدعت في التفنن بقتل السوريين وتدمير بلدهم وتهجيرهم”.
وأضاف: “على من يريد إجبارنا على ذلك أن يتذكر أنه لم يقبل حلولاً مماثلة مع هتلر. على المعارضة أن تعلن على الملء رفضها كل هذا المسار التفاوضي العبثي وإنهاء مهزلة (اللجنة) الدستورية و(مسار) أستانة”.
العربي الجديد
—————————
تبعات فيديو الغارديان: من استطاع منكم النوم؟/ كمال اللبواني
بعد خروج أي مشاهد للعلن عن جريمة ارتكبها أحد الفرقاء المتصارعين يعلو صوت الطرف الثاني ليبرر ما ارتكبه أو سوف يرتكبه من جرائم مشابهة، لكنها مبررة بالقصاص، ومحولاً لها لعمل شريف ومقدس، فالقتل المقدس والتعذيب والوحشية المقدسة هي صفة كل الممارسات التي تقوم بها المكونات المتصارعة والتي تجدد تاريخها الدموي بواسطته وتورثه للأجيال القادمة.
المشكلة تكمن في النمطية التي توصف بها المكونات بحيث يصبح الجميع مدان بجرم البعض، والأجيال القادمة مسؤولة عن سلوك السلف، والمشكلة أن كل طرف يدّعي امتلاك حق القصاص على جريمة حدثت في مكان وزمان معين، بعد أن يقتطعه عن مكانه وزمانه وشخوصه، ويحوله إلى أسطورة ولعنة تلاحق مكوناً ثقافياً دينياً قومياً معيناً بمجمله، وأن كل طرف لا يعرف من بدأ ومن انتقم، فهذه الصراعات ذات جذور عميقة في رحم التاريخ، ولا يعرف أيضاً كيف ينهي ويدفن ذلك الصراع الوحشي المتجدد بلا بداية وبلا نهاية، كدوامة للعنف والقتل نعيش بها وعليها، ونجدد بآلياتها تلك صراعنا وتخلفنا، والمشكلة أن كل طرف يحاول أن يجد في مقدساته أو يدسّ فيها أو يفسرها بحيث يجعل من انتقامه وقصاصه عملاً مقدساً، فالآخر هو عدو الله قبل أن يكون عدواً لنا، وهو هدف مستباح شرعاً وعرفاً، وهكذا نستمر في تلك الدوامة من دون نهاية.
لم نتعلم إلى اليوم كيف ندفن صراعاتنا وننتقل لدولة القانون التي يحاسب فيها كل فرد على أي جريمة بشكل مستمر وعلى الجميع من دون تمييز، لكي لا يصبح الانتقام منه أو من أهله هدفاً مشروعاً لذوي الضحية، فمكا قال الله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، فنظام العدالة الدقيق والصارم والشامل والمستمر، يدين أي جريمة ويحاسب مرتكبها بغض النظر عن تكوينه وانتمائه، وهذا هو المخرج الوحيد من الوحشية التي عاشتها الجاهلية العربية قبل الإسلام، كذلك المخرج الوحيد لنا للخروج من الجاهلية الوحشية التي ما نزال نعيش فيها، والسبب دوماً وأبداً هو تبرير الجريمة، وتغييب العدالة.
المطلوب إدانة الجريمة من الجميع، وعدم تبريرها بجريمة أخرى، المطلوب تطبيق العدالة على الجرائم التي تقع منذ الآن وبشكل دائم ومستمر، لكي نستطيع الخروج من العنف والحرب الأهلية الدينية الطائفية القومية القبلية، للسلم الاجتماعي ودولة القانون، ولا بد من مرور فترة زمنية كي تتراجع ذاكرة تلك الآلام الرهيبة التي تسببت بها تلك الجرائم، لكن بتجديد التحريض وبمساعي الانتقام خارج القانون، سنستمر في الصراع وستستمر الجريمة التي سنرتكبها بأيدينا ونكون ضحية لها بنفس الوقت.
ليفانت – كمال اللبواني
—————————–

مذبحة التضامن في سوريا: كيف ساعد الإنترنت باحثين على ملاحقة القاتل ونزع اعتراف منه؟
إبراهيم درويش
نشرت صحيفة “الغارديان” تحقيقا أجراه مراسلها في الشرق الأوسط، مارتن شولوف، حول مذبحة حي التضامن القريب من دمشق.
ويحكي شولوف قصة عنصر صاعد في ميليشيا موالية للرئيس بشار الأسد أعطي لابتوب يعود إلى واحد من أجهزة الأمن سيئة السمعة في النظام السوري وطلب منه إصلاحه. وعندما فتح الشاشة ونقر على ملف الفيديوهات، ظهرت اللقطة غير ثابتة في البداية قبل أن تقترب إلى حفرة تبدو جديدة بين بنايتين تظهر آثار الرصاص عليهما. وبدا رجل أمن يعرفه راكعا قرب الحفرة ويرتدي قبعة صيد وزيا عسكريا ملوحا ببندقيته ويصدر أوامره.
وتجمد العنصر الجديد وهو يشاهد الصور تظهر تباعا حيث اقتيد رجل من مرفقه باتجاه الحفرة الضخمة ولا يعرف ما فيها وطلب منه الركض بسرعة، يلاحقه الرصاص الذي اخترق جسده قبل أن يسقط على كومة من الجثث. وواحدا بعد الآخر أمر رجال بالركض أو السير باتجاه الحفرة حيث قيل لهم إن الأمن يحميهم من القناصة وصدق بعضهم أنهم في حماية الأمن. وفي نهاية العملية قتل 41 شخصا في مقبرة جماعية وتم صب الكاز عليهم وحرقهم لإخفاء آثار الجريمة في مكان لا يبعد عن مقعد السلطة في سوريا سوى مسافة قصيرة. ويعود تاريخ الفيديو إلى 16 نيسان/إبريل 2013.
وأصيب العنصر الجديد بالغثيان حيث قرر في ذات نفسه أن اللقطات يجب أن ترى في مكان آخر، مما قاده في رحلة محفوفة بالمخاطر بعد ثلاثة أعوام، قادته من سوريا باتجاه الأمان في أوروبا، ثم تعاون مع أكاديميين حاولا الوصول إليه كمصدر رئيسي في تحقيق خارق للعادة وتأمينه، وفي الوقت نفسه تحديد الرجل الذي أشرف على المذبحة وإقناعه بالاعتراف بدوره فيها.
وهي قصة جريمة حرب تم تسجيلها بشكل حي على يد المنفذين لأوامر واحد من أجهزة النظام سيئة السمعة وهو فرع 227، جهاز الاستخبارات العسكرية. وهي قصة تقدم تفاصيل دقيقة عن الطريقة التي تم فيها قلب الطاولة على مرتكبيها، بما في ذلك الطريقة التي قام فيها باحثان في أمستردام بإغراء واحد من الضباط سيئي السمعة عبر شخصية بديلة على الإنترنت وخداعه بالكشف عن أسرار حرب الأسد الشريرة.
وكشف عملهم عن الجرائم غير المسبوقة التي اعتقد أن النظام ارتكبها ولكنه أنكرها وحمل الجهاديين مسؤوليتها. ويقول شولوف إن دليل الجريمة والإرهاب في سوريا يتم تكراره اليوم وبعد 9 أعوام في أوكرانيا حيث تحولت العملية التي أطلق عليها الرئيس فلاديمير بوتين “العملية العسكرية الخاصة” إلى احتلال وحشي لأجزاء من شرق البلاد. وكانت وحدات الاستخبارات العسكرية في هذه العملية في مقدمة من ارتكب الوحشية وزرع الخوف في قلوب السكان من خلال الاعتقالات الجماعية والقتل الذي يشبه محاولات الأسد الوحشية التمسك بالسلطة.
وتعلمت قوى الاستخبارات السورية التي تلقت تدريبها في الاتحاد السوفييتي السابق أثناء فترة الستينات من القرن الماضي، فن التخويف، لمن يعتقلون على نقاط التفتيش بدون اعتبار لولاءاتهم، فقد كان الخوف هو الوسيلة القاتلة المتوفرة للنظام واستخدم كل ما لديه لزرعه في القلوب. ولم يكن الضحايا من المتمردين بل المدنيين الذين لم يكن لهم ناقة أو بعير لدى جانبي الصراع. وكانت رسالة قتل المدنيين في حي التضامن واضحة: لا تفكروا حتى بمعارضتنا.
وسرب المصدر الفيديو أولا إلى ناشطة في المعارضة في فرنسا وهي أنصار شهود والبرفسور أوغور أوميت أوغور من مركز الهولوكوست والإبادة بجامعة أمستردام، حيث كان عليه مقاومة الخوف من الاعتقال والقتل بالإضافة للضغط النفسي الناتج عن نبذ عائلته العلوية له. وكان على أنصار وأوغور العثور على الرجل في قبعة الصيد، واستخدما في هذه المحاولة الشيء الوحيد الذي اعتقدا أنه مساعد في العملية: شخصية بديلة.
وكانت أنصار ناقدة حادة للأسد مع أنها تنتمي إلى عائلة كانت على علاقة جيدة مع النظام إلا أن النزاع والانهيار الاقتصادي أثر على العلاقات وجعلها مصممة على تقديم الأسد للعدالة، مهما كان الثمن. وانتقلت إلى بريطانيا عام 2013 وإلى أمستردام بعد عامين حيث التقت مع أوغور، وكلاهما كانت لديه رغبة بتوثيق ما اعتقدا أنها إبادة ارتكبت في سوريا. وكان تجميع الشهادات من الناجين، طريقة واحدة وكذا الحديث مع الجناة طريقة أخرى، أما كسر شيفرة الصمت المحيطة بالنظام، فقد كانت شبه مستحيلة.
وقررت التحول للإنترنت والبحث عن المسؤولين الأمنيين في النظام والتظاهر بأنها معجبة وتدعم قضية النظام. وقال أوغور “المشكلة مع نظام الأسد أن من الصعب دراسته، فلا تستطيع المشي في دمشق ملوحا بيدك وتقول أنا عالم اجتماع من أمستردام وأريد طرح أسئلة” و”توصلنا لنتيجة أننا بحاجة إلى شخصية ويجب أن تكون بنتا علوية شابة”. ووجدت أنصار أن الجواسيس والضباط في سوريا يستخدمون فيسبوك، ولم يكونوا رغم عملهم السري يخفون نشاطهم على منصات التواصل ولهذا قررت اختراع اسم “آنا ش” وطلبت من مصور صديق التقاط صورة مغرية لوجهها. وحولت صفحتها إلى مديح للأسد وعائلته وبدأت بتجنيد الأصدقاء.
وبحثت في فيسبوك على مدى عامين عن مشتبه بهم محتملين، وعندما وجدت أحدا أخبرته أنها باحثة تدرس نظام الأسد. وأصبحت جيدة في تخفيها، وفهمت النظام، ورتبت مع أوغور النكات والقضايا التي تساعدها في الطريق الذي اتخذته. وتحولت آنا ش بعد فترة لشخصية معروفة لدى رجال الأمن بل الملجأ للكشف عن الهموم. وقالت أنصار “كانوا يبحثون عن شخص للتحدث معه ومشاركته في التجربة”. وقال أوغور “أصبح بعض الأشخاص مرتبطا بآنا” و”صار بعضهم يحادثها منتصف الليل”. وعلى مدى عامين جسدت أنصار الشخصية التي تبنتها لدرجة أنها شعرت بالغضب، والكثير ممن تحدثت إليهم كانوا جزءا ناشطا في آلة القتل، وكان هناك أشخاص جزء من النظام “كابال” الذي ساعدهم. كل هذا أثر على صحتها وحياتها الاجتماعية وصفائها، إلا أن الجائزة كانت تستحق لو عثرت على المسلح.
وحدث الاختراق في آذار/مارس 2021، فقد استطاعت صفحة آنا جذب أكثر من 500 معجب من مسؤولي النظام المكرسين له. ومن بينهم شخص وجهه مثل القمر بندبة وشعر بارز على الوجه، وأطلق على نفسه أمجد يوسف، ويشبه المسلح الذي ظهر في الفيديو وأتعبت نفسها بالبحث عنه. وبعد ذلك تلقت أنصار أو آنا ش معلومة من مصدر في التضامن أن القاتل كان ميجر في فرع 227 في المخابرات العسكرية السورية. وتقول “كان الارتياح لا يوصف” و”هنا شخص يحمل المفتاح وعليك دفعه للحديث”. إلا أن أمجد في المكالمة الأولى كان شاكا وأنهى المكالمة بسرعة. ثم دفعه الفضول للتحدث معها مرة ثانية بعد ثلاثة أشهر. وعندها ضغطت أنصار على زر التسجيل. وكان مقتصدا في الكلام ومتعثرا، وفعلت آنا كل ما بيدها لجعله يتكلم من خلال الضحك والتغنج حتى ارتاح الوجه المتجمد وبدأ بالحديث، وسألته عن التضامن.
ثم قالت “كيف يكون وضعك لو جعت ولم تكن قادرا على النوم وتقاتل وتقتل وتخاف على والديك، وهذه مسؤولية كبيرة تحملها على ظهرك؟”. وأصبح أمجد في كرسي التحقيق وأجابت آنا على كل أسئلته. وتقول أنصار “لا أنكر أنني شعرت بالنشوة للحديث معه” و”ابتسمت لأني كنت أتحدث معه” وكان هذا جهد سنوات للكشف عنهم وليس مقابلة واحدة، ويجب إقناعهم بأنك تقوم بدراسة. وظلت أنصار وشخصيتها البديلة أمام الشاشة طوال صيف العام الماضي وبحضور أوغور بعيدا عن الشاشة وهي تحاول إقناع أمجد والدخول في عقله وجعله يتحدث وجمع المعلومات.
ودخلا صفحته على فيسبوك حيث عثرا على صورة لشقيقه الأصغر وقصيدة كتبها بعد وفاته عام 2013، وأربعة أشهر قبل مذبحة التضامن. وفي وقت متأخر من حزيران، تلقت رسالة عبر فيسبوك، وكانت هذه فرصتها لجعله يعترف. وكان مرتاحا هذه المرة، وسألته عن شقيقه، وقال “كان عليك عمل ما يجب عمله” و”قتلت كثيرا وانتقمت”، ثم أغلق المكالمة ولم يرد على المكالمات لأشهر إلا من خلال الثرثرة حيث سأل عن آنا ومتى ستعود إلى سوريا. وبدأ يتصرف كصديق غيور لها. وشعرت أنصار أن شخصيتها البديلة قد وصلت حدها وأنه يجب على آنا ش أخذ راحة، فقد اتصلت مع حوالي 200 مسؤول في النظام، بعضهم متورط في جرائم مباشرة وساعدوا الأسد في حربه الشرسة، وبدأوا يتداولون بين أنفسهم حول المرأة اللغز.
وقررت في يوم بارد من كانون الثاني/يناير هذا العام دفن الشخصية في محمية طبيعية خارج أمستردام، حيث طبعت مع أوغور كل المراسلات في صفحتها. وحان الوقت للتركيز على المعلومات التي جمعاها ولم يكن لديهما وقت لتحليلها. وظلت مهمة وحيدة لم يقوما بعملها وهي مواجهة أمجد بجريمته. وأرسلت أنصار، وهذه المرة باسمها الحقيقي، عبر فيسبوك لقطات قصيرة من 14 ثانية من الفيديو. وكان أول سؤال طرحه، هل أنا في هذا الفيديو؟ نعم، “نعم هذا أنا، لكن ماذا يقول الفيديو؟ أنا أعتقل شخصا وهذه هي مهمتي”.
وعندما اكتشف تداعيات ما رآه، بدأ ينفث غضبه على قوات الدفاع الوطني الذي ينتمي العنصر الصاعد إليه ووصفهم بالقتلة والبلطجية. وقال إنه لم يكن مثلهم. ثم غير نبرته وكتب إليها رسالة “أنا فخور بما فعلت” وهدد بقتلها وعائلتها. وتوقفت أنصار وأوغور عن التواصل مع أمجد ومنعاه من ذلك منذ شباط/فبراير، مع أنه حاول الوصول إليهما. ويعرف تداعيات هذا الاعتراف مع بدء المحاكمات في ألمانيا ضد أعضاء في نظام الأسد. وما كشف عنه في المحادثات هو دليل أقوى من تلك التي توفرت للمحاكم الألمانية.
وفي نهاية الدراما كان هناك شخص يجب توفير الأمن له، المصدر الذي وفر اللقطات، وكانت رحلة الخروج من سوريا صعبة، حيث سافر من دمشق إلى حلب، ولم يستطع الخروج إلا بعد رشوته ضابطا في الفرقة الرابعة في الجيش السوري بـ 1.500 دولار ومنها سافر إلى تركيا حيث التقته أنصار هناك.
القدس العربي
—————————————
============================
تحديث 30 نيسان 2022
—————–
القاتل بحاجة للتحدث إلى امرأة: عن “آنا” التي خدعت عناصر النظام السوري/ كارمن كريم
بطلة السوريين هذه المرة هي امرأة، اختارت التمرد على القبيلة والديكتاتور وأوقعته في الفخ مستخدمة أساليبه، فأمال المجرم رأسه المثقل بالمجازر على كتفها، وأنزل دموع التودد لتفهم معنى المجزرة التي ارتكبها، لكنه لم يعلم أنه يُسلّم مفاتيحه إلى عدوته وهكذا سقط أمجد يوسف في قبضة العدالة التي جاءت على شاكلة امرأة هذه المرة.
وهكذا وثق تحقيق “الغارديان” الذي أعده الباحثان أنصار شحود (آنا) وأوغور أوميت أونجور، مجزرة التضامن عام 2013 بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته.
قد يكون طول الظلم الذي تعرض له السوريون سبباً في دفعهم إلى اليأس، فمن لم يحصل على العدالة خلال 11 عاماً يشك بحصوله عليها الآن، فالحروب تنمو في أماكن أخرى، والأزمات تُضيّق الذاكرة على جراحهم، فتُنسَى” كأنها لم تكن” بتصرف عن محمود درويش، قد يكون سؤال السوريين الأكبر هل نُسِينا واندثرت أوجاعنا في خضم المآزق الكبرى؟! يخشى المتألمون أن ينسى الآخرون أوجاعهم، الآخرون الذين وقفوا إلى جانبهم مرة وصدحوا بالعدالة…
لكن هذه المرة كان لبطلتنا اسماً وهو انصار شحود وكأن اسمها الأول يشي بالعدل والحقيقة، كأنها وجِدت في ذلك المكان من العالم لتجرَّ القاتل إلى الحقيقة. انصار فتاة من طائفة احتفظت بعلاقات جيدة مع نظام بشار الأسد، كلفتها معارضة النظام كثيراً، من بينها القطيعة مع عائلتها، لكنها اختارت طريق العدالة على القبيلة، ولأن أفضل طريقة لكشف القاتل هي التقرب منه، خلقت أنصار والباحث أور أوميت أونغر شخصية آنا ش. وهي فتاة علوية من الطبقة الوسطى، داعمة للأسد، وبدأ العمل. يبدو أن وجود فتاة كان مؤثراً إلى حد كبير بعناصر النظام، إذ وصلت دائرة آنا في بداية عام 2021 إلى حوالى 500 عنصر من النظام السوري، تمكنت من صنع هذه الدائرة استناداً إلى نقطتين أساسيتين، الأولى أنها علوية مؤيدة للنظام والثانية هي إعجابها بإنجازاتهم، حركت النقطة الثانية الذكورية الأسدية التي تقوم على أفعال القتل والاغتصاب والإهانة، وبات الإعجاب بوابة لفتح أحاديث مطولة، لكن الإعجاب سيكون مشكوكاً به لو لم تكن علوية، عناصر النظام من الطائفة العلوية يمتلكون حكماً مسبقاً وقطعياً وهو أن الانتماء للطائفة يعني الانتماء الحتمي للأسد وهو ما لعبت عليه أنصار بذكاء.
تعلق بعض العناصر بآنا، وصار بعضهم يتصل بها في منتصف الليل، وهكذا تحولت آنا من مجرد رفيقة للعناصر في حبها للنظام وجيشه إلى ملجأ يهربون إليه، وغدت امرأة تشاركهم تفاصيل حياتهم، همومهم، جانبهم الإنساني القابع تحت جرائمهم، قبلت آنا بهذا الدور، وهو ما أنهكتها نفسياً، لكنها استمرت لأن هدفها كان الوصول إلى القاتل الرئيسي الذي يظهر في مجزرة التضامن في الفيديو، مع العلم أن كثيرين ممن تحدثت معهم هم قتلة.
أمضت آنا الكثير من الوقت وهي تبحث وتتعرف إلى أشخاص جدد عساها تصل إلى قاتل مجزرة التضامن، وفي يوم وبينما كانت تقلب بعض الصور في إحدى الصفحات، لمحت وجهاً مألوفاً وندبة واضحة فوق الحاجب الأيسر، نعم لقد وجدته في النهاية، تمكنت لاحقاً من التأكد من اسمه وعمله بمساعدة مصدر داخل حي التضامن، لكن أمجد حتى وإن قبل صداقتها فلن يكون صيداً سهلاً فالقاتل سيكون حريصاً وستثير آنا ريبته، إلا أن جهود آنا، ابتسامتها الرقيقة وتعاطفها مع صعوبة حياة أمجد ستجعله يلين، وكأن أحداً جاء ليؤكد له أنه المظلوم في هذه الحكاية… ربما احتاج أمجد إلى امرأة تقول له، أنت الضحية ولست القاتل، حتى يسترسل في الحديث. وهكذا تحولت آنا إلى صديقة ومعالجة نفسية، وما عزز ثقته بها أنها لم تطلق أي أحكام بحقه، يبدو أن القتلة أيضاً بحاجة لامرأة يتكلمون معها.
بكل الأحوال ستصل الشخصية المختلقة إلى حد معين، فتثير الشكوك حولها وستنتهي طاقة آنا، فمن هي تلك الفتاة التي تواصلت مع مئات العناصر، بعضهم شارك بطريقة مباشرة في عمليات القتل، ولذلك بدأ أولئك العناصر يتساءلون عن قصة الفتاة الموجودة في مراسلاتهم جميعاً.
لا شك في أن مساعدة المجند في تسريب التسجيلات كان لها دور كبير، لكن وجود آنا كان الحد الفاصل في القصة فما كان قبلها ليس كما جاء بعدها، انصار انتصرت للنساء السوريات بذهابها أبعد مما قد يتخيله عناصر النظام فأوقعتهم في المصيدة، فأن تشارك امرأة سورية في كشف مجرم كبير كأمجد يوسف هو شكل من تصحيح كل الانتهاكات والذكورية التي تتعرض لها النساء في سوريا على يد هذا النظام وقوانينه المجحفة.
درج
————————-
أمجد يوسف ترس في آلة القتل الأسدية/ سمير الزبن
لم أستطع إكمال مشهد من المشاهد الكاملة المنشورة على مواقع التواصل عن مذبحة حي التضامن في دمشق التي حدثت في عام 2013، كما جاء في تحقيق صحيفة الغارديان البريطانية، ليس لأنني اتخذت قراري مبكّراً بألا أطبّع نفسي مع مشاهد القتل، وأعتاد القتل مسألة عادية، بعد استباحة عصابات القتل الأسدية سورية، بل هو سبب شخصي آخر، جعل ترويع هذه المشاهد مضاعفاً بالنسبة لي، أن مصير هؤلاء وغيرهم ممن قضوا في مذابح جماعية في سورية كان يمكن أن يكون مصيري الشخصي، كان يكفي أن أكون في المكان الخطأ والزمان الخطأ في دمشق، حتى يكون مصيري بين هؤلاء، خصوصاً وأن “التضامن” الذي جرت فيه هذه المذبحة الجماعية حي ملاصق لمخيم اليرموك الذي ولدت فيه وقضيت عمري فيه، حتى خروجي من البلد بعد أقل من عامين من انطلاق الاحتجاجات في سورية.
للقتل وظيفة سياسية، أو للسياسة وظيفة القتل في بلد مثل سورية، هذا لا يبرئ القاتل المباشر من جريمته، يدينه ويحيله، في الوقت نفسه، إلى مجرم أكبر. المجرمون الصغار (التروس) يدورن في فلكه (آلته) ويأتمرون بأمره. لم تُبنَ آلة القتل الأسدية وتصمّم في صراع قمع الاحتجاجات السورية التي انطلقت مارس/ آذار 2011، إنما قبل ذلك بوقت طويل، وعند انطلاق الاحتجاجات كانت جاهزةً لحصد أرواح السوريين في كل المدن والبلدات والقرى التي جرت فيها مظاهرات معادية للنظام. تنتمي آلة القتل التي فتكت بالسوريين إلى مؤسّسها الحقيقي، حافظ الأسد، فهو مصمّم نظام الإبادة في سورية، فمن تسلم نظام الحكم في سورية عمل، وبشكل حثيث، على تحكيم أجهزة المخابرات، ليس في حياة الناس العاديين فحسب، بل باتت هذه الأجهزة هي الحاكمة، وبإشرافه وإدارته طبعاً، للجيش أيضاً، وبذلك جرى اعتقال الأمن العسكري الذي بات متحكماً بالوحدات العسكرية المؤسّسة العسكرية السورية، بدلاً من أن تكون الأركان العامة وأركان الوحدات العسكرية هي المتحكّمة في وحداتها، وبات أمن الوحدات العسكرية، بصرف النظر عن حجمها، من فصيل إلى فرقة، تعود أمور الوحدة فيها حقيقةً إلى ضابط الأمن في الوحدة. وهو ليس القائد الأعلى للوحدة العسكرية، أي جرى إخضاع الرتب الأعلى إلى الرتب الأصغر في الوحدات العسكرية، لشلّ قدرة الجيش على القيام بانقلاب عسكري مرة أخرى بعد تسلم الأسد الأب السلطة في سورية، وهذا ما نجح فيه الأب. تجلّى هذا النجاح في اختبار الثمانينيات التي أدار فيها النظام مذابح ضد السوريين، خصوصاً في حماة وحلب وإدلب، بحجة مواجهة إرهاب “الإخوان المسلمين”. ويمكن اعتبار هذه الفترة من تاريخ سورية في مطلع الثمانينيات هي التي استطاع فيها الأسد الأب لا تحكيم أجهزة المخابرات في البلد، بل وتجفيف السياسة أيضاً من خلال القضاء على طيف القوى السياسية في سورية، بيمينها ويسارها، ولم يبقَ سوى الهياكل الفارغة لما تسمّى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي يُمنع أعضاؤها من العمل في الجيش وبين الطلاب. أي أنها كانت غطاء شكلياً للأسد القابض شخصياً على كل مفاصل البلد.
عندما أنزل النظام الدبابات في مواجهة المتظاهرين في الأيام الأولى للاحتجاجات في درعا كان واضحاً أن النظام اختار سياسة القتل في مواجهة هذه الاحتجاجات، أو أنه لا يملك سوى هذه الآلة التي تركها الأب لابنه، آلة قتل فتّاكة ومجرّبة، ولم يكن على الابن الوارث للسلطة من أبيه، من دون أن يملك خبرات أبيه، سوى أن يكبس زر التشغيل لآلة القتل التي اخترعها وصمّمها الأب. وحتى تقوم هذه الآلة بدورها، كان على رأس النظام، الأسد الابن، أن يجمع أمثال أمجد يوسف والذين يديرونه، وهم أكثر إجراماً، ويطلقهم لينهشوا اللحم السوري بأبشع الطرق. ويُحصي تحقيق “الغارديان” 288 ضحية في مقاطع الفيديو الـ 27 التي حصلوا عليها، صوّرت بكاميرا بجودة عالية، وليس بهاتف موبايل، وواضح أن التوثيق لم يكن من أجلهم، بل وثّقوا ما قاموا به من أجل قادتهم ومشغليهم. وكرّر يوسف تبريراً لما قام به لأنها “مقتضيات وظيفته” وهي الذريعة نفسها التي قدّمها إيخمان في محاكمته على الجرائم التي ارتكبها بوصفه ضابطاً نازياً بحق اليهود؛ أنه قام بوظيفته أيضاً.
ليست المرّة الأولى التي يوثّق فيها النظام جرائمه، فقد سبق أن كشف قيصر أنه جرى تكليفه رسمياً بتصوير خمسين ألف صورة لأحد عشر ألف ضحية قُتلوا تحت التعذيب في السجون السورية. والسؤال: كم الأفلام التي توثّق المذابح الموجودة اليوم في أرشيف فروع المخابرات في سورية، لمذابح في طول البلاد وعرضها، خصوصاً أن فرع المنطقة الذي يعدّ مسؤولاً عن المذابح في المنطقة الجنوبية ليس أشرس الفروع وأكثرها قسوة، فهناك فرع أمن القوى الجوية (قاده جميل الحسن)، والذي أبدى استعداده لإبادة مليون سوري، وبعد ذلك يذهب إلى المحكمة.
ما مارسه النظام في سورية ضد شعبه ليس عمليات قمع، بل عمليات إبادة جماعية، وعلى سنوات، جعلت أعداد السوريين تتناقص، ليس عن طريق الهجرة فحسب، بل حتى عن طريق القتل، والتي لا أحد يعرف أعداد القتلى والمفقودين على وجه الدقة فيها. وحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تخطّى عدد قتلى الحرب في سورية 350 ألف شخص، وهناك عدد لا يُحصى من المفقودين في البلاد. وأعتقد أن الأرقام ضِعف تقديرات المنظمة الدولية.
بات من الضروري محاكمة مجرمي الحرب في سورية، في مقدمتهم رأس النظام، من أجل تقديم العدالة إلى الضحايا وذويهم. استمرار رأس النظام في الحكم وصمة عار في جبين العالم كله. وإذا كان من الصحيح ما تقوله حنا أرندت “أعظم الشرور في العالم يرتكبها أشخاص نكرات”، فإن محاكمة هذه النكرات ليست من أجل الشماتة بها، بل لإنصاف الضحايا.
العربي الجديد
———————-
المجزرة المستمرّة في سورية/ معن البياري
لمّا قتلت في عام 1956 قوةٌ إسرائيليةٌ من حرس الحدود 43 فلسطينيا من قرية كفر قاسم، أجهزت عليهم في ساعةٍ واحدة. ولمّا قتلت وحدة شاكيد في جيش العدو عشرات الأسرى المصريين في سيناء في حرب 1967، كان جنودٌ منها يُجبِرون بعضَهم على حفر قبورهم بأيديهم، قبل أن تسير دباباتٌ فوقهم. ولمّا أزهقت قوةٌ من هذا الجيش في 1948 أرواح نحو 250 فلسطينيا في قرية الطنطورة، كانت تُكرِه بعض الضحايا على حفر خنادق ليُطلَق النار عليهم فيها، وقد أعدّت لهم حفرةً بطول 35 مترا صارت مقبرةً جماعية لهم. يقول أحد جنود وحدة ألكسندروني شارك في المذبحة إنه لا يعلم عدد الذين قتلهم هو وزملاؤه. وفي الكشف الاستقصائي الذي نشرته صحيفة الغارديان عن مذبحةٍ مروّعةٍ في حي التضامن الدمشقي، اقترفها في العام 2013 مجرمو حربٍ في المخابرات العسكرية السورية، ضمن ما تسميها السلطة هناك “قوات الدفاع الوطني”، يقول أحد هؤلاء، أمجد يوسف، إنه قتل كثيرين، ولا يعرف عددَهم. وليس قولُه هذا رجع صدىً لقولة ذلك الجندي الإسرائيلي القاتل في الطنطورة قبل 74 عاما وحسب، وإنما أيضا هو تأكيدٌ لصفة نظام آل الأسد في سورية قوة احتلال، فالشناعاتُ المشهودةُ في مجازر واعتداءاتٍ على مدنيين آمنين فلسطينيين (ولبنانيين ومصريين و..) قارَفها المحتل الإسرائيلي، منذ قام، وجيء أعلاه على نزرٍ منها، ليس عسيرا أن يلقى واحدُنا متشابهاتٍ كثيراتٍ بينها وبين جرائم حربٍ إرهابيةٍ ارتكبها هذا النظام منذ قام، بأجهزته المخابراتية والعسكرية والبوليسية العديدة، ضد المخطوفين الأسرى في سجونه (من السوريين وغيرهم)، وفي مذابح حماه وسجن تدمر وجسر الشغور ثم في الحولة وجديدة الفضل وكرم الزيتون وتفتناز وداريا ومعرّة النعمان والبيضاء والزارة و.. (ليس في وسع ذاكرةٍ فرديةٍ عدّها).
المشترك الأهم بين قوتي الاحتلال، الأسدية في سورية والإسرائيلية في فلسطين، انعدام الحساسية بشأن القتل، بأي كيفيةٍ ولأي سببٍ وتجاه أي ناسٍ أغيار، إنْ يستحقون التصفية لأنهم “عُصاة” وأخطارٌ محتملة، كما رفاقٌ لحافظ الأسد في “البعث” والسلطة والدولة، أو كانوا ناسا في بيوتهم ومساجدهم وكنائسهم ومخابزهم ومشافيهم ومدارسهم، كما يشهد على هذا بابا عمرو والبياضة في حمص، ومضايا والغوطتان في ريف دمشق، وشرقي حلب، وغير هذه الأسماء في جغرافيا الرعب السوري المديد. وما أفضى به أمجد يوسف، على ما وثّقه كاتبا تحقيق “الغارديان”، بحرفيةٍ مهنيةٍ عالية، يؤكّد هذه البديهية، فالرجل، كما كل العاملين في آلة التمويت في أجهزة القمع والقهر والفتك في سورية، لا يستشعر أنه اقترف ما هو خارج الطبيعة الإنسانية للبشر. لا يقع على ما هو بهيميٌّ في شخصِه، على قطيعيّة مسلكه مستخدَما أداةً في ماكينةٍ لن تعترف له بأي امتنانٍ أو ميزة بطولة وهو يقتل، وهو يحرق جثث قتلاه في حفرة، قبل أن يرميهم أحياء فيها.
لسائلٍ أن يسأل: أين تعلّم أمجد يوسف وصاحباه، القتيل لاحقا نجيب الحلبي، وفادي صقر، وأمثالهم، هذا التفنّن في قتل من يقول إنه كان ينتقم منهم، فيما هم سيقوا إلى المذبحة من حقولهم ومنازلهم وأماكن أرزاقهم وأشغالهم، وبينهم نساء وأطفال؟ من أين تغذّى أمجد، ومن هم من طينته، بكل هذه الأحقاد التي تجعله (وجعلت غيرَه) يصوّر جريمته لإمتاع نفسِه في مشاهدته لها، بزهو؟ لم يكن، ومن معه، في قلقٍ، أو يتحسّبون من طارئٍ ما يباغتهم، وهم يقتلون ضحاياهم المغدورين ويحرقونهم، ويصوّرونهم باحترافيةٍ روتينية (بتعبير كاتبي “الغارديان”). كانوا يؤدّون واجبا وطنيا، أو مقتضىً وظيفيا (بتعبير أمجد نفسه)، فيغشاهم فرحٌ به. يحتاج الوقوعُ على تفسير، سايكولوجي أو غيره، لهذا الشذوذ المتوحّش، إلى علومٍ ومعارف لا يتوفر عليها صاحب هذا التعليق، إنما يجتهد ويقول إنه الشعور المستحكِم لدى أمجد ومسؤوليه والحاكمين في قصر المهاجرين وفي أجهزة السلطة والجيش والأمن بأن سورية لهم وحدهم، وعلى الآخرين أن يغيبوا، بالقتل في حفرةٍ أو بغاز السارين أو بالتجويع أو بغارةٍ على مدرسةٍ أو مستشفى. إنه الشعور نفسُه في مدارك كل جندي إسرائيلي أو عنصر في عصابات الصهاينة المبكّرين، يرى أرض “يهودا والسامرة” له ولكل يهوديٍّ مثله. ومن شواهد بلا عددٍ على هذا الزعم أن المجزرتين مستمرّتان في سورية وفي فلسطين، وأن ما قاله أمجد يوسف قال شبيها له ذلك الجندي الإسرائيلي في 1948 في الطنطورة، كلاهما لا يدري أعداد من قَتلا.
العربي الجديد
————————–
عن الصلح بين القتيل وقاتله/ عبد الله الحريري
يولد الإنسان ويولد معه موته، في سباق يطول أو يقصر إلى نهاية معلومة لكنها مجهولة الزمان والمكان والشكل، وكثيراً ما يغيب عن بال الغارق في مشاغل الحياة وأفراحها وهمومها، فيأتي، أي الموت، مباغتاً ومنتصراً بامتلاكه عنصر المفاجأة، يأتي وحيداً ولمرة واحدة (من اللامكان على الدوام، من ظلمة اللاوجود من دون ماض أو مستقبل)، ومن هنا يشبهه زيجمونت باومان بالحب، وسريعاً يذهب فكأن شيئاً لم يكن، والحزن توأم الموت، حتى قيل (لا شماتة بميت) فحتى العداوة تبتلع لسانها في لحظة الغياب الجليلة، لأنه كأس على كل البشر، كقول الشاعر:
يا أيها الشامت المُبدي عداوته ما بالمنايا التي عيّرت مِن عارِ
تراك تنجو سليمًا مِن غوائلِها ؟! هيهات لا بدّ أن يسري بك الساري
وأذكر كيف كانت تُسدل ملاءة على التلفاز فلا ترفع قبل مرور أسابيع على موت أحدهم، قريباً كان أم غير قريب، أما الآن فقد أصبح قماش الحزن رقيقاً سرعان ما تأكله حشرة النسيان، وانحسرت طقوسه إلى برمجة ساعات العزاء وفي المواساة الإلكترونية، كأننا نقاوم الموت بالتجاهل، وننقي أكبر عدد من ساعاتنا من ذكره أو مروره.
لكن هذا لا يصح في جميع الظروف، فحين يخسر الموت عنصر المفاجأة ويصبح متوقعاً، يتحول إلى رفيق لحوح غير محبّذ، وهذا ما يحصل تماماً في الحرب والمعتقل والحصار، نصادق موتنا أملاً في وفائه ونصدّق القاتل توهماً لطيبته، فنُساق بالصراخ والقيود البلاستيكية والحديدية إلى غرف التعذيب، نُضرب ونُصعق بالكهرباء ونُشبح ونُركل، والأهم من ذلك أننا نتوسل، ليس لإيقاف الألم بل لعدم إيقاف الحياة، كأننا نقول لهم: “خذوا انتقامكم البطيء من أجسادنا الهزيلة، ولكن لا تدعوا الموت يقترب أكثر”، ويتحول شبح السجان/الشيطان الذي يقتادنا إلى غرفة التحقيق لملاك وهو يعيدنا إلى غرفة السجن، حيث يبدأ الألم وتعود صورة القاتل في أذهاننا إلى حقيقتها.
والأمر أهون من ذلك، وإن كان أشد فتكاً، في الحرب، إذ يحضر هدير الطائرات وأزيز القذائف وشخير البراميل المتفجرة بدلاً من صوت السجان، وعشوائية سقوطها بدلاً من القيود، والاحتماء بالجدران والأقبية بدلاً من توهم رحمة القاتل، وعلى الرغم من أن النتيجة تكون ذاتها في كلتا الحالتين؛ كثير من الضحايا وقليل من الناجين، وعلى الرغم من أن إرادة القاتل هي المسبب لهما بالدرجة نفسها وبلزومية العقاب نفسها، إلا أن الموت الآتي عبر المعدن والبارود أهون من الموت المباشر بيد بشرية؛ في العلاقة مع الصواريخ والقذائف يبقى الحظ حاضراً، ويحافظ الموت، بعض الشيء، على قَدَريّته، فلا أصح من (خبط عشواء) في وصفه وهو قادم من قبة السماء الزرقاء عبر برميل متفجر، أما موت الأعزل تحت التعذيب أو بإطلاق النار أو الذبح أو الحرق فيبدو بشرياً أكثر من كونه قَدَرياًّ، وفيه من السخرية ما يكفي لتحريك رغبة الانتقام وتمنّي موت القاتل في اللحظة نفسها ويبعث على الشماتة بموته أو قتله.
لقد عشنا كشعب سوري مع مرويّة المجزرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، قصف وقتل وبقر بطون وحرق، وأسرار التعذيب والإعدام في سجن تدمر وصيدنايا والمزة وغيرها، لكنها بقيت سردية في أذهاننا، كأجيال جديدة، أكثر من كونها حقيقة، ولعلها محاولة للدفاع عن ذاكرتنا، فكيف لي أن أتخيل أن زميلي على مقاعد الدراسة في كلية الطب البشري هو ابن السجّان الذي حرّق بالسخّان الكهربائي جسد الأستاذ سليمان ابن قريتنا في سجن تدمر؟! كان لا بد من النسيان أو التناسي، لكي نستطيع تنفس الأكسجين ذاته، لكي تفصل 10 سم من الإسمنت في السكن الجامعي بين أبناء الضحايا وأبناء القتلة كجيران لا كسجين وسجّان، لكن ذلك لم يُجد نفعاً إذ كانت جذور الجريمة تمتد كعروق سوداء إلى أيدي جناة جدد!
لم تكن المجزرة الأخيرة التي رفع عنها الستار وارتكبت في حي التضامن عام 2013 الوحيدة ولا الأكبر من بين المجازر التي اقترفها النظام في جنوبي دمشق، كحال جميع مناطق سوريا، إذ تبتدئ مجازره هناك من انطلاقة الثورة عام 2011، ومن قصفه لتشييع في بلدة حجيرة أودى بعشرات الضحايا، ومن ثم مجزرة على حاجز سبينة، وبعدها مجزرة في بيت سحم حين حاول بعض الأهالي الفرار من الجوع والحصار، فارتدى عدد من متطوعي الإسعاف في مشفى فلسطين ألبسة الهلال الأحمر الفلسطيني لانتشال عدد من الجثث ومنعوا من سحب البقية، وأذكر أن أحدهم رأى رضيعة تبكي في حضن أمها المسجّاة لكنه لم يستطع سحبها، كما استطاع الفرار من أحد سجون حي التضامن السريّة فتى لا يتجاوز الخامسة عشر من عمره، فروى لنا ونحن نعالجه من جروح في جسده عن اقتياده من حاجز الفرن الآلي على مدخل مخيم اليرموك من جهة التضامن إلى دكّان تغطي الدماء جدرانه وفيه ثلاث جثث، وساعده نحوله على الهرب من نافذة صغيرة كان قد تزعزع حديدها، وصُفي أيضاً عدد من الذين حاولوا الخروج من مخيم اليرموك عبر طريق الريجة، ومنهم ممرضون كانوا يعملون كمتطوعين في مشفى فلسطين، ومن بعدها أتت مجزرة شارع علي الوحش حيث فُقد أكثر من ألف ومئتي شخص ما بين نساء وأطفال ورجال وشيوخ، ورُوي عن تصفيات مباشرة بإطلاق النار، وحشر أشخاص في إطارات بلاستيكية وحرقهم، واغتصاب النساء، ونجا البعض القليل جداً، بينما لا خبر عن بقيتهم!
بعد خروجي من مخيم اليرموك عقب سيطرة جبهة النصرة ولاحقاً داعش عليه أقمت في بلدة يلدا على مقربة من جامع أمهات المؤمنين، حيث قُتل بإطلاق النار عدد ليس بالقليل قبل سيطرة فصائل الجيش الحر عليه، وشاهدت مقاطع مصورة لجثث المدنيين التي عُثر عليها، وعشت قرابة سنتين هناك، وأنا أتخيل اقتيادهم وربط أيديهم وركنهم إلى الجدران وإطلاق النار عليهم وانتفاض أجسادهم، لكني لم أكن أتخيل سلوك القتلة بعد ذلك، الأمر الذي فضحته الفيديوهات الصريحة في المجزرة المعلنة حديثاً والتي يعود وقتها إلى عام 2013 أي في الوقت الذي نجا فيه فتى نحيل الجسم من نافذة دكان في التضامن حوّله المجرمون لمسلخ بشري، كأن يشعل القاتل سيجارة فوق حفرة الجثث، وأن يهدي قتله لكل هؤلاء المدنيين العزل إلى روح أخيه المسلح، وأن تستمر عملية القتل والحرق والطمر لزمن يتجاوز ما تحتمله أي روح بشرية حتى وإن كانت روح مجرم، ومن الناحية الأخرى هذا الإيهام الجبان للضحايا بأنهم سيتجاوزون قنّاصاً، وعدم منحهم لحظة أخيرة قبل الموت، لقد أوقعوهم في الهاوية بالفعل، ويبدو ذلك أكثر إجراماً، فما الفارق إذن بينهم وبين داعش؟! إذا ارتادوا النوادي الرياضية وشربوا الخمور وارتدوا بزّاتهم العسكرية يصبحون أناساً طبيعيين وعلى المجتمع أن يتقبّلهم على أنهم نفّذوا مهامهم ليس إلا؟! أي مرحلة من الوحشية يصل إليها العالم لتحصل المجازر فيه على امتداد خطوط الطول والعرض دون أن يحرك أحد ساكناً؟! أما نحن الضحايا الذين نجونا من المجزرة لأننا فقط لم نمرّ من ذلك الشارع فنتمثل قول محمود درويش:
خذوا أرض أمي بالسيف
لكنني لن أوقّع باسمي معاهدة الصلح بين القتيل وقاتله.
—————————
حياة طبيعية للقاتل/ رشا عمران
القاتل رومانسي. هذا ما تكشف عنه صفحته على “فيسبوك”، الصفحة التي أغلقت بعد ساعاتٍ من ظهور تقرير صحيفة الغارديان، وانتشاره في “السوشيال ميديا”. ربما في تلك الساعات الممتدة بين ظهور التقرير وإغلاق الصفحة، لم يكن القاتل يستخدم “فيسبوك”، ليس لأنه مشغولٌ بعمليةٍ وطنيةٍ أخرى، فهو كما اعترف لآنا (الشخصية الافتراضية) كان متضايقاً من أنّ عمله قد تحوّل إلى عمل مكتبي مملّ، بدلاً من الميداني المليء بالإثارة. ربما كان ما حدث أنّ الكهرباء كانت مقطوعةً لديه في المكتب، وليس بإمكانه تصفّح الشبكة لتمضية الوقت، ذلك أنّ امتيازاً كالكهرباء الدائمة في سورية ليس من حق جميع القتلة. عند الامتيازات، سيتحوّل هؤلاء إلى مواطنين مهمّشين، مثلهم مثل ضحاياهم، أو على الأقل إلى مهمّشين فخورين بمساهمتهم في الانتصار على أعداء الوطن وإرهابييه.
نشر القاتل سابقاً على صفحته (في المتاح رؤيته لغير الأصدقاء) أغاني رومانسية وقصائد لنزار قباني، وعرض صوراً جميلة لقريته، ونشر صوراً برفقة أصدقاء له، يمجّد فيها الصداقة، وصوراً لشقيقه (الشهيد)، متحدّثاً عن مفهوم الأخوة وعن قيمة التضحية والشهادة، وصوراً لطفله، متفاخراً به كأي أبٍ آخر. ولا نعرف إن كان الطفل سيكبر بوصفه “ابن المؤسسة”، كما هو، وكما كبر والده مقتفياً أثر أبيه. والقاتل مؤمن أيضاً، إذ وضع على صفحته آيات من الذكر الحكيم، إذ “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه…”.
يعيش القاتل مثل جميع البشر، ويتصرّف مثل بقية البشر. لا يبدو أنّ ما فعله قد سبّب له أرقاً ما، أو حتى وخزاً خفيّاً في الضمير، فحتى اعترافه لآنا الافتراضية بجريمته جاء نتيجة إحساسه بالفراغ والتهميش، إذ غالباً، كان يعتقد أنّ جريمته تلك ستؤهله لأن يكافأ بالعمل في مكانٍ أفضل، قريباً ربما من “السيد الرئيس”، حيث يتمكّن من خدمته وجهاً لوجه، بدلاً من الاكتفاء بتوثيق ما فعله لأجله وأجل عائلته.
تصلح حكاية أمجد يوسف بكل ما فيها، حسب تقرير “الغارديان” والترجمات عنه، لأن تكون دليلاً على البؤس السوري وخرافة الشعب العظيم، منذ ابتليت سورية بحكم آل الأسد؛ إذ ينتمي أمجد إلى أسرةٍ ريفيةٍ فقيرة كبيرة العدد. ارتبط والده بالمؤسسة الأمنية وربط أسرته كلها بها، لكونها السبيل الوحيد للعائلة لتدخل في الطبقة المتوسطة، العائلة التي تنتمي إلى طائفة “السيد الرئيس”، مثل كثيرين من أشباهها، اختلط لديها مفهوم الوطن بالطائفة؛ تلك أول الكوارث التي قصمت ظهر سورية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي: القضاء على الهوية الوطنية المواطنية الواحدة لمصلحة هوياتٍ صغيرةٍ متفرّقةٍ وقاتلة: عائلة، عشيرة، مذهب، طائفة، طبقة، مصلحة، إلخ. ومع أول زلزال أمني حدث في عام 2011، ظهرت تلك الهويات بكل طاقة الرعب التي راكمتها عبر سنوات، وحصل ما حصل.
نعرف، نحن السوريين، أسراً كثيرة مشابهة لأسرة أمجد يوسف، ونعرف آباء مثل أبيه تحوّلوا، بعد انتهاء خدمتهم العسكرية والأمنية، إلى رجال دين لطوائفهم أو زهاداً أو متصوّفة، من دون أن يعرف أحد، حتى أقرب الناس لهم، حجم ما ارتكبوه من “إثم” وجرائم، ويعيشون حياتهم كما لو أنهم لم يفعلوا شيئاً، إذ هذا أيضاً شأنٌ باطني، لم يكن يسمح بالحديث عنه، وطالما نجوا من المحاسبة، فإن ما فعلوه شأن يتعلق بوظائفهم ومهنهم، في “المؤسسة” كما أسماها أمجد بدقة؛ لكن حتى اللحظة لم يتمكّن أحد من معرفة لماذا وثّق المجرمون جرائمهم ومجازرهم بعد الثورة؟ هل هناك سببٌ نفسي لذلك، أم أنّ الأمر يتعلّق فقط بتوافر إمكانات التوثيق عبر الهواتف المحمولة، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً، مع إدراكهم أنهم محميون من العقاب والمحاسبة، واعتقادهم أنّ أفعالهم كلها في خدمة الوطن، فلمَ لا يتباهون بها إذاً؟
من سوء حظ أمجد أنه وثِق، في لحظة شعوره بالتهميش والخذلان، بشخصية ظنّ أنّها حقيقية، وأنّها تؤمن بما يؤمن به، ففضحت جرائمه. أقول من سوء حظه، لأنّ هناك مئات مثله من مرتكبي الجرائم والمجازر، ما زالوا يعيشون حياتهم كما لو أنهم لم يفعلوا شيئاً، يستمعون إلى الموسيقى ويقرأون شعراً ويصوّرون مناظر خلابة، ويغازلون زوجاتهم وحبيباتهم برومانسية، ويقبّلون أطفالهم قبل النوم، لكنهم سيُصبحون منذ الآن أكثر حذراً في الإفصاح عمّا ارتكبوه، وقد يعدمون أي دليلٍ مادّيٍّ أو معنوي، قد يشكّل خطراً عليهم ذات يوم.
العربي الجديد
————————–

عنف المخابرات والشبيحة وأركانه الخمسة/ علي الجاسم
في بحث استقصائي موسع، كشف الباحثان أنصار شحود وأور أونغور الخيوط عن سلسلة من المجازر المروعة التي أشرف عليها وقام بتنفيذها عناصر من فرع الأمن العسكري – فرع المنطقة (227) في حي التضامن في دمشق حيث تظهر المواد المصورة دليلاً لا لبس فيه يدين الجناة والمؤسسات التي ينتمون إليها مستوى العنف الممنهج الذي تتبناه هذه الأجهزة وزبانيتها من الشبيحة.
المجرم أمجد يوسف وهو يغتال الضحايا في مجزرة التضامن – المصدر: غارديان
وهنا يأتي السؤال كيف ولماذا تلجأ الحكومات والأنظمة لمثل هذه الأنواع من الأعمال؟ فالعنف الذي ترتكبه منظمات القمع السرية [المخابرات والشبيحة] هو عنف مركب يقوم في أساسه على خمس ركائز أساسية:
الحصانة والإفلات من المحاسبة
القرب والحميمية في ارتكاب الجريمة
السرية والغموض حول تنفيذ العنف
التعميم في الاستهداف
الإنكار وسهولة التنصل من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة
وإذا ما تناولنا هذه الركائز الأساسية بالتفصيل فإن رؤساء المجموعات على الأرض يطلقون العنان لمرؤوسيهم لارتكاب المجازر والتي تكثفها عبارة “’بكل الوسائل المتاحة” في كتبهم ومراسلاتهم السرية. بذلك يتم منح المنفذين ضوءاً أخضر لارتكاب الفظائع حيث يتم إدراج الضحايا في خانات “العمليات التطهيرية العسكرية” وفي أحسن الأحوال “ضحايا عرضيين”.
وأما الركيزة الثانية وتعتبر الأكثر رمزية من بين الركائز الأخرى والتي تعبر عن مدى إصرار الجاني على ارتكاب فعل العنف والتنصل من إنسانيته والشعور بالآخر وحقه في العيش. وإذا ما تناولنا هذا الفعل وقارناه بعمل آخر من الأعمال الحربية مثل استخدام سلاح الجو والبراميل المتفجرة والصواريخ بعيدة المدى، فإن المنفذ يحافظ على مسافة تفصل بينه وبين ضحيته بحيث يمكن التصالح مع الفعل لكونه ضرورة عسكرية وميدانية.
والجدير بالذكر أنه وفي بعض الأحيان وفي حالات الدمار الواسع فالضحية تأخذ فرصة أخرى بالعيش والنجاة في حال تعرضت لإصابة متوسطة أو طفيفة. أما في حالة المخابرات والتنظيمات شبه العسكرية فإن الجاني يعد ويرتب مسرح الجريمة مسبقاً ويعرف تفاصيل بالحد الأدنى عن ضحاياه فيتفنن ويستلذ في فعل القتل والإبادة الذي يرتكبه على حيوانات لا تستحق العيش في منظوره، وبعدها يقوم بطمس خيوط ومسرح الجريمة.
وهذا يقودنا للركيزة الثالثة ألا وهي السرية حول فعل الإجرام أو المجزرة. فمنذ اللحظة الأولى من احتكاك الجاني بالضحية تنقطع كل أشكال التواصل مع العالم الخارجي بما في ذلك أسرته وأقرب الناس إليه.
ينفرد هنا الجناة بحصرية التعاطي مع ضحاياهم ومصائرهم والذي ينتهي في الغالب إلى الحتف كما يكشف تبرير أحد الجناة الذي يعتبر عملية الاعتقال والحراسة وإطعام الضحايا بأنها عبء على كاهل الدولة ومؤسساتها “فيصبح من السهل التخلص من هؤلاء الأشخاص (الضحايا) بالميدان في أثناء القيام بعملية عسكرية أو مهمة” بدلاً من إيداعهم.
وهنا يعمد المنفذون إلى إخفاء مسرح الجريمة بأفعال تتدرج بين حرق الجثث أو طمرها في آبار مهجورة أو رميها في الأنهار الجارية.
أما الركيزة الرابعة فهي التعميم في الاستهداف. ويحضرني هنا تعليق أحد رجالات نظام الأسد وهو حيدرة ابن اللواء بهجت سليمان، أحد مستشاري الأسد وسفيره السابق إلى الأردن، معلقاً على الانتقادات التي كانت تطول النظام لاستخدامه البراميل المتفجرة في حلب عام 2014. حيث قال: “البراميل براميلنا والأرض أرضنا وين ما بنشلفهم بنشلفهم، ما حدا خصه”.
هذه العبارة فيها تكثيف لمنهجية النظام في عقاب أحياء ومدن كاملة خارجة عن سيطرته والتي يطلق عليها بمخطاباته الرسمية “حاضنة الإرهاب الشعبية” لتبرير العقاب الجماعي لقاطني منطقة ما مستهدفة.
والحال نفسه يسري على المخابرات والشبيحة من حيث التعميم في استهداف ضحاياهم، بحيث يكفيهم فقط إلقاء القبض على أحدهم بمجرد وجودهم في مسرح عملياتهم. وبذلك فمن الممكن تبرير عمليات القتل على أنها ضرورات أمنية أو حتى تواطؤ مثل هؤلاء الضحايا مع أشخاص معادين للنظام آخذين بعين الاعتبار بأن لديهم ضوءاً أخضر وتفويضاً من رؤسائهم في تنفيذ أعمال العنف لاستعادة النظام العام لمنطقة ما.
ومن هنا فإن الجناة يلجؤون إلى الركيزة الأخيرة ألا وهي آلية الإنكار والتنصل من المسؤولية حيث يصبح من الصعب تتبع خيوط الأوامر في سياقات المجازر المرتكبة من قبل جماعة سرية تكون فيها علاقة العناصر ببعضها البعض شخصية وليست مهنية أو مؤسساتية.
فمن هو ذلك الشخص الذي سيشي بأخيه أو أعز أصدقائه؟
البديل هنا هو إنكار ارتكاب المجزرة بإلقاء اللوم على الآخر بزعمه أنه من مصلحة ذلك الآخر تشويه سمعة [الدولة] كونها الجهة الشرعية المخولة باستخدام العنف.
لقد رأينا ذلك في حالات كان واضحاً فيها تورط أجهزة النظام، مثل الهجوم الكيماوي على الغوطة في صيف 2013 ومن قبلها مجزرة نهر قويق في حلب من خلال إلقاء جثث ضحايا تم تصفيتهم على عجل في نهر يمر من مناطق سيطرة المعارضة.
في النهاية، هناك توجه متزايد في الآونة الأخيرة لتناول أجهزة المخابرات وآليات عملها على الرغم من كونها صندوقا أسود محاط بالسرية التامة والتكتم عن حيثيات أنشطتها، بما في ذلك سياقات الدول التي تعتبر نفسها تتمتع بحكم ديمقراطي يخضع للمساءلة أمام العامة. وفي الخط نفسه تتركز حالياً نزعة باتجاه دراسة الجناة بتموضعهم في مؤسساتهم الأمنية والتنظيمات النشطة تحت ظلها من أجل فهم التركيبة من القاعدة إلى الهرم، إذا كانت دراستها هيكلياً غير متاحة أو قابلة للتنفيذ.
يتطلب هذا جهداً كبيراً من حيث الأدوات والمنهجية، ناهيك عن الصبر والتأني من أجل إكمال صورة الأحجية التي قد تصل قطعها التي تركب صورتها الألف قطعة.
———————————
فتاة سورية تخترق مخابرات الأسد../ عبد القادر المنلا
استطاعت “آنا” الفتاة السورية التي أطلقت على نفسها اسماً افتراضياً على الفيس بوك وادّعت أنها من مؤيدي النظام، استطاعت اختراق مخابرات الأسد والوصول إلى الكثير من المعلومات والحقائق والاعترافات الموثقة بالصور والفيديوهات عن انتهاكات كبيرة وجرائم وحشية ارتكبها أتباع الأسد ضد السوريين الذين شاركوا في رفع صوتهم عند انطلاق الثورة السورية..
ليس الفيديو الذي انتشر بالأمس وتناقلته معظم وسائل الإعلام، وعلى رأسها صحيفة “الغارديان”، والذي يتضمن وقائع الإعدامات الميدانية في حي التضامن بدمشق، والتي تم ارتكابها على يدي عنصر الأمن “أمجد يوسف”، التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، أو ما يطلق عليه بالأرقام الفرع ٢٢٧ وزميله “نجيب الحلبي” اللذين قاما بإعدام ٢٨٠ شخصاً في يوم واحد من أيام عام ٢٠١٢، وتعد تلك واحدة من المجازر التي لا تحصى من مجازر الأسد، ليس هذا الفيديو سوى واحد من عشرات الفيديوهات التي حصلت عليها “آنا” والتي باتت تصلح أرشيفاً موثقاً موازياً للأرشيف الشعبي الميداني الذي وثقه ناشطون بأدوات بدائية دون أن يهتموا بالجانب الاحترافي، حيث لم تترك كثافة الجرائم وقتاً ولا مبرراً للتفكير في صناعة شكل احترافي ولم يكن السوريون يعتقدون أن توثيق الجريمة يتطلب كل ذلك، كما أنهم لم يكونوا محترفين ولا خبراء قانونيين، بل مجرد ناشطين اعتقدوا أن المجتمع الدولي يقف بالمرصاد لكل القتلة ولا يمكن أن يتسامح معهم..
وقد عمل النظام على مدار سنوات طوال، بل ومنذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها الثورة على التشكيك بمحتوى كل الفيديوهات والصور والأخبار والتقارير التي توثق لجرائمه، بل وإنكارها وتحميلها لجهات أخرى أو إرجاعها إلى ممارسات فردية في أحسن الأحوال..
ومع تعقد المشهد، وكم التشويش الذي مورس على القضية السورية، وتواطؤ المجتمع الدولي وخذلانه للسوريين، وأيضاً مع الجرائم الكثيرة التي تم ارتكابها من قبل فصائل تحسب نفسها على الثورة السورية، بالإضافة إلى ضخ المليارات من قبل النظام وداعميه لخلط الأوراق والتشويش على حقيقة ما يحدث، راح المجتمع الدولي يتلكأ ويجعل من تفاصيل قانون جرائم الحرب حائلاً أمام اعتماد المشاهد المروعة التي تنقلها فيديوهات الناشطين السوريين كدلائل وقرائن على الجريمة المنظمة وجرائم الاعتقال والاغتصاب والقتل تحت التعذيب والإبادة الجماعية والتهجير والتغيير الديموغرافي..
هنا، كان على السوريين المضطلعين بقانون الجريمة الدولية أن يغيروا شكل التعامل ويحاولوا العثور على قرائن لا تقبل التشكيك والاحتمالات، وأن يعيدوا توثيق ما تم ارتكابه فعلاً ولم يعتمد رسمياً في القانون الدولي، بطريقة لا يستطيع النظام الدولي أن يتنصل من مسؤوليته تجاهها..
تنكرت “آنا” بزي مؤيدة واستدرجت الكثير من القتلة للاعتراف صراحة بجرائمهم التي ارتكبوها وقد نجحت في جرّهم إلى ذلك الاعتراف دون أن يداخلهم شيء من تعذيب الضمير أو الندم، بل ظهروا بالصوت والصورة متفاخرين متباهين بتلك الجرائم.
غير أن طريقة الاستجابة للفيديو الأخير الذي كتبت عنه صحيفة الغارديان يثير تساؤلاً جوهرياً ويضعنا أمام ملاحظة تبدو إجرائية وشكلية ولكنها هامة للغاية ولا يمكن تجاهلها، وتتعلق بإغفال الإشارة إلى أصحاب الجهد الأساسيين ومفجري الموضوع، وعلى رأسهم الباحثة السورية أنصار شحود، وزميليها: السوري مهند أبو الحسن، والهولندي البروفيسور “أور أوميت أونغر”، فالصحف التي نشرت -بما فيها الغارديان- لم تكن سوى وسيلة، أما الجهد الحقيقي الذي استطاع الوصول إلى المجرمين واستدراجهم وسحب اعترافاتهم، فكان لهؤلاء الثلاثة، وكان نتيجة عمل دؤوب استمر لسنوات، ولكن نجومية صحيفة الغارديان تغري المتابعين بالتركيز عليها دون غيرها والتعامل معها على أنها صاحبة الفضل في الكشف عن ذلك الفيديو ونسيان أنها كانت وسيلة النشر لا صاحبة البحث..
درست “أنصار شحود” قانون الجريمة الدولية وتخصصت به أكاديمياً لسنوات طويلة واعتمدت منهج بحث أكاديمي علمي ودقيق تحت إشراف البروفيسور الهولندي “أور أوميت أونغر” المتخصص في دراسات الهولوكوست والمجازر الجماعية وبمساهمة فاعلة من الباحث السوري مهند أبو الحسن لإعادة صياغة الحقائق التي يعرفها السوريون جيداً، ويعرفها أيضاً المجتمع الدولي برمته ولكنه لم يكن يعتمدها بذريعة نقص الاحترافية والافتقار إلى القرائن القانونية الصرفة.
هل كانت صور وفيديوهات الاعتقالات والقتل العلني غير مقنعة؟ هل كانت آلاف الصور وفيديوهات التعذيب غير مقنعة؟ هل كانت صور الطائرات التي تلقي البراميل المتفجرة أقل شأنا من محتوى هذا الفيديو؟
إن افترضنا ذلك كله فالمجتمع الدولي الآن لا يستطيع أن يداور أو يشكك في صحة الفيديو الجديد، فماذا هو فاعل؟ هل ستكون هذه الدلائل الاحترافية والقانونية الجديدة مجرد زوبعة تستمر لعدة أيام ثم تنام وتنضم إلى أخواتها من الأدلة التي وضعت في الأدراج؟ هل سيكتفي المجتمع الدولي ببعض التصريحات ثم يغلق الملف كما أغلق مئات الملفات التي سبقته؟ أم ثمة إجراء فعلي قد يتم اتخاذه؟
استطاع الباحثون إثبات مدى هشاشة مخابرات الأسد وغبائهم وغباء عناصر الأمن الذين اعتمدوا الوحشية والبطش لا المهنية، واستندوا إلى القوى الداعمة سياسياً وعسكرياً ثم ظنوا أنهم انتصروا باعتبارهم الأذكى والأقوى
لا ضمانة للمجتمع الدولي الذي غالباً ما تقتصر ردة فعله على إدانة أدوات الجريمة لا المجرم الحقيقي، إدانة من نفذ فقط، وتناسي من أعطى الأوامر ومن أعطى حرية القتل لأولئك المرتكبين، هذا إن فعل، ثم نعود مرة أخرى إلى الدائرة العبثية القديمة ذاتها، إلى العقاب الذي تم اعتماده ضد الأسد أثناء استخدامه الكيماوي في الغوطة، والذي اكتفى بإدانة السلاح ومصادرته -إن كان فعلاً قد صادره- وتبرئة مستخدمه؟
في كل الأحوال، استطاع الباحثون إثبات مدى هشاشة مخابرات الأسد وغبائهم وغباء عناصر الأمن الذين اعتمدوا الوحشية والبطش لا المهنية، واستندوا إلى القوى الداعمة سياسياً وعسكرياً ثم ظنوا أنهم انتصروا باعتبارهم الأذكى والأقوى.
كما كشف الباحثون عن مدى تخاذل المجتمع الدولي، فالفيديوهات التي لا يستطيع إنكارها اليوم، لا تختلف كثيراً عن الأدلة التي شكك فيها بالأمس، الأمر الذي يعطي مصداقية مطلقة لكل الفيديوهات الأخرى التي رفعها الناشطون على وسائل التواصل منذ بدؤوا بنشرها..
كان قانون قيصر هو آخر إجراء ضد نظام الأسد، ورغم مرور سنوات على اعتماد هذا القانون، والذي يقتصر على عقوبات اقتصادية، فإنه لم يحدث أثراً حقيقياً على النظام، ثم بدأ المجتمع الدولي بالتراخي وإيجاد المخارج للتخفيف من آثاره رغم قلتها وضعفها، واليوم نجدنا أمام امتحان جديد للنظام الدولي، امتحان يوقن معظم السوريين أن نتيجته لن تكون أكثر مما سبقه من امتحانات صعبة، فهل يفعلها العالم ويتحرك هذه المرة، أم يؤكد شكوك السوريين في خذلانه لهم وتواطئه وصمته عن أعتى قضايا الإجرام التي شهدها العصر الحديث؟
———————————-
الخارجية الأميركية عن مذبحة التضامن:ملتزمون بمحاسبة الأسد
دانت وزارة الخارجية الأميركية بشدة الفظائع التي وثّقها مقطع مصور لإطلاق النار على مدنيين معصوبي الأعين وغير مسلحين من قبل مسؤول في نظام بشار الأسد.
ويظهر الضحايا في المقطع وهم يسقطون في مقبرة جماعية في مذبحة قيل إنها شملت “مئات المدنيين”، في حي التضامن قرب العاصمة السورية دمشق.
وأكد الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن المقطع الذي يوثق لمذبحة العام 2013 في حي التضامن، يشير إلى “أدلة إضافية لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد”، وهو “مثال مروع آخر على الفظائع التي عانى منها الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمان”.
وأثنى بيان المتحدث على “الأفراد الشجعان الذين يعملون على تقديم الأسد ونظامه إلى العدالة، وغالبا ما يتعرضون للخطر على حياتهم”. وقال إن وزارة الخارجية تواصل دعم العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني السورية لتوثيق انتهاكات قانون النزاع المسلح، وكذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وجهودها للنهوض بالعدالة الانتقالية.
وجدد البيان التزام “حكومة الولايات المتحدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين”، مشيراً إلى أن المساءلة والعدالة عن الجرائم والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السوريين ضرورية لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أكد لموقع “الحرة” الخميس، أن الولايات المتحدة ملتزمة “بمحاسبة النظام السوري على الفضائع التي ارتكبها بحق شعبه”. وأوضح المتحدث أن “النظام السوري مسؤول عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، إضافة لاستمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل”.
وقال إنه “من دون المساءلة لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للصراع. نحن نؤيد الدور الهام للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، كما نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها والمرتكبة في سوريا”.
ووثّق تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أعده الباحثان أنصار شحود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام، الجريمة واسم مرتكبها وصورته.
وتقول الغارديان إن “هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 الذي يعرف بفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية”، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.
وأشار التحقيق إلى أنه “عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب”.
ويقع حي التضامن خارج البوابة الجنوبية لمدينة دمشق القديمة، على أطراف حي الميدان الدمشقي، وإلى الجنوب الغربي من حي باب شرقي الذي يعتبر قلب الحياة الليلية الصاخبة لمدينة دمشق.
ومع انطلاق التظاهرات في مختلف أحياء دمشق في ربيع العام 2011، شهد الحي احتجاجات سلمية، ليرد النظام السوري على ذلك عبر إنشاء “مجموعات الشبيحة”، وهي ميليشيات قامت بقمع الاحتجاجات بطريقة شديدة العنف.
——————————-
تسعة مجرمين وعشرات المذابح.. من هم مرتكبو مجازر حي التضامن في دمشق؟ فمن هم هؤلاء المتورطون؟ وكيف شاركوا في جريمة المجزرة؟ وأين هم اليوم بعد مرور 9 سنوات على ارتكابها؟
المتورطون في مجزرة التضامن
1-أمجد يوسف، مرتكب المجزرة الرئيسي، من مواليد قرية نبع الطيب 1986 في سهل الغاب بمحافظة حماة. مساعد أول يتبع للفرع 227 (فرع المنطقة)، ويظهر في مقطع الفيديو وهو ينفّذ عمليات إعدام جماعية بطريقة شنيعة لـ41 مدنياً في حي التضامن. كان يوسف مسؤولاً عن الحي وارتكب فيه العديد من الانتهاكات خلال عام 2013، وكان اسمه دائماً يتردّد مع بعض العناصر التابعين لـ ميليشيا “الدفاع الوطني”، لكون شارع نسرين هو جزء من حي التضامن الذي ينحدر منه بعض عناصر تلك الميليشيا، التي كان يقودها (فادي صقر) المُشارك في المجزرة.

2- نجيب الحلبي من مواليد 1984، وهو من سكان حي التضامن ومعروف أيضاً بلقب “أبو وليم”. ابنُ عائلة درزية تنحدر من قرية حرفا بجبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، ولكنه ولد وترعرع في حي التضامن. وبحسب صحيفة “الجمهورية” كان نجيب يدير ملهى في منطقة باب شرقي قبل اندلاع الثورة. وبعد اندلاع الثورة أنشأ أول مجموعة من الشبيحة في التضامن، متخذاً لها مركزاً على خط الجبهة بجوار جامع عثمان، ما جعل منه “بطلاً” في نظر الموالين لنظام الأسد.
ظهر نجيب في فيديوهات مجزرة التضامن وهو يقف على حافّة القبر الجماعي ويدخن سيجارة ويبتسم للكاميرا أثناء إلقاءه جيرانه في الحفرة لإعدامهم ومن ثم حرقهم وهم قتلى أو مصابين.

3 -صالح الرأس “أبو منتجب”، الذي قاد مرحلةً من الرعب في التضامن، أطلق عليه زملاؤه أثناءها لقب “هتلر سوريا” وله شارب خفيف يشبه شارب هتلر.
ينحدر من قرية الطليسية في ريف حماة الشرقي.
شغل “أبو منتجب” قائد القطاع الشرقي للدفاع الوطني والمسؤول العسكري عن منطقة التضامن. وكان قبل ذلك قد تقاعد من الجيش برتبة مقدم.
وذُكر اسم “أبو المنتجب” في فيديو مجزرة التضامن، عندما صرخ أحد القتلة بعبارة “لعيونك أبو المنتجب”.
وحصل الرأس على شهادة تكريم من قيادة القوات الروسية في سوريا.

4- ياسر سليمان، من قرية عين فيت، وهو مدير المكتب الأمني في حي التضامن والمشرف المباشر على المجزرة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “عين المدينة” في العام 2019، فإن ياسر سليمان الملقب بـ”أبو إيليا”، يملك مطعماً فخماً في منطقة مشتى الحلو في ريف طرطوس، أطلق عليه اسم (ناي). وكان قائد الحاجز الشهير قرب الفرن الآلي بحي الزاهرة الجديدة الملاصق لحي التضامن.
وهذا الحاجز يعرفه الآلاف من سكان الزاهرة والتضامن وغيرهم من سكان مخيمي اليرموك وفلسطين، منذ إنشائه في العام 2012 وحتى إزالته في 2018، إذ شكل هذا الحاجز خلال تلك السنوات هاجساً لكل من يمر عبره، ولكل من يسكن في دائرة نفوذه، لا سيما في الزاهرة والتضامن.
كان أبو إيليا قادراً على اعتقال من يشاء ثم إخفائه ومطالبة ذويه بفدية مالية كبيرة وإلا فمصيره الموت، فـ “أبو إيليا” لا يحب تحويل أحد إلى المخابرات وإرهاق “الشباب” هناك بالتحقيق مع المعتقل وتعذيبه وسجنه وإطعامه، بل يفضل أن يحسم الأمر بسرعة. “معكن 24 ساعة بس وإلا بيتقطع تقطيع وبرميه للكلاب السود”، هذه مهلته لذوي المعتقلين لجلب الفدية التي بدأت بنصف مليون، ثم أخذت تزيد شهراً بعد آخر من عمر الحاجز لتصل إلى (10) ملايين، وفق تقرير “عين المدينة”.

5- فادي صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق. وبحسب “مرصد الانتهاكات وجرائم الحرب في سوريا”، يعدّ صقر العقل المدبر في المجموعة وقائد الشبيحة في التضامن، وهو رجل خمسيني، ومتهم بالكثير من جرائم الاغتصاب. تربطه علاقة مقربة مع بشار الأسد.

6- هواش حمدان، من قرية عين فيت، مساعد أول في فرع المنطقة. (متوفى- أكتوبر 2021).

7- حسام عباس، من قرية عين فيت. وهو حالياً يعرّف عن نفسه كـ “إعلامي” و”سياسي”.

8- صابر سليمان، من قرية عين فيت، قتل في إحدى الغارات الإسرائيلية.
9- حكمت صالح “أبو علي حكمت” من منطقة القطيلبية بريف جبلة في محافظة اللاذقية. قتل في حرستا بريف دمشق في تشرين الأول 2014.
———————
بشار الأسد يصدر “عفو” على وقع رعب “مجزرة التضامن”
أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد مرسوماً تشريعياً حمل رقم “7”، وقضى بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه ردود فعل السوريين بخصوص “تحقيق مجزرة التضامن” الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، قبل أيام.
وكشف التحقيق عن جريمة حرب نفذها عنصر في مخابرات النظام السوري يدعى “أمجد يوسف”، قبل ثماني سنوات (في 2013)، حيث حي التضامن الدمشقي في محيط العاصمة.
ولا يشمل الإجراء الذي اتخذه الأسد، بحسب وكالة “سانا” “الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته”.
وذكرت الوكالة، اليوم السبت، أن “العفو لا يؤثر أيضاً على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها رأس النظام هكذا نوع من المراسيم، وخاصة في الفترة التي تستبق الأعياد.
وكثيراً ما أوضح حقوقيون أن مراسيم العفو تأتي في مسعى إعلامي من جانب النظام السوري لـ”تحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، التي ارتكبها بحق السوريين، منذ عام 2011.
وفتح الكشف عن “مجزرة التضامن” قبل أيام جروح الكثير من السوريين، سواء من أبناء العاصمة دمشق ومحيطها أو باقي المحافظات السورية.
كلما تابعتُ مذبحة من مذابح بشار الأسد ضد الشعب السوري، مثل #مجزرة_التضامن، يحار عقلي من #عمائم_السوء في طهران ودمشق، وجرأتها على الله تعالى بمشاركتها في تنفيذ هذه الفظائع وفي تسويغها.. #مجزرة_حي_التضامن pic.twitter.com/qkNgeN3XJe
— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 29, 2022
ووثق التحقيق الخاص بالمجزرة الذي أعده الباحثان أنصار شحّود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته.
وأظهر التسجيل المصور عناصر من مخابرات نظام الأسد، وهم يعدمون عدد من المدنيين وهم معصوبو الأعين، وأيديهم مقيدة، قبل دفعهم إلى حفرة وإطلاق الرصاص عليهم قبل حرقهم، في حي التضامن بدمشق.
وكأننا جميعنا قُتلنا هنا، نحنُ من سقطنا يا عم وانت ارتفعت الى الله #مجزرة_التضامن pic.twitter.com/SLUmMpM9yv
— آلاء (@alaadh01) April 28, 2022
وكشف التحقيق عن هوية الجناة، على رأسهم أمجد يوسف، والذي كان يشغل بعج عام 2011 منصف صف ضابط “مُحقِّق”، في فرع المنطقة أو الفرع 227، وهو فرع تابع للأمن العسكري “شعبة المخابرات العسكرية”.
#مجزرة_حي_التضامن التي كشفت بعض جوانبها صحيفة #الغارديان هي غيضٌ من فيض جرائم نظام الأسد الدموي ضد الشعب السوري.
لا تُعينوا ظالماً على ظلمه. pic.twitter.com/rC3kRr7yYn
— عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) April 29, 2022
———————————-
تجويع وحصار واعتقالات.. أجواء مهدت لمجزرة “التضامن“
روى صحفي سوري تفاصيل وجوانب من مجزرة “التضامن” التي وقعت في 16/نيسان ابريل/2013، وذهب ضحيتها 41 مدنيا من أهالي الحي والمناطق المجاورة، بينهم شبان وأطفال ونساء قبل أن يكشفها تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية منذ أيام.
وأشار الصحفي “مطر اسماعيل” الذي كان يعيش جنوب دمشق حينها لـ”زمان الوصل” أن المجزرة وقعت في الجزء الجنوبي الشرقي من الحي الواقع جنوب دمشق الذي كان النظام يسيطر على ثلثيه بينما تسيطر المعارضة على الباقي، خلال الفترة التي سادت فيها أجواء استعدادات الثوار للدخول إلى العاصمة دمشق وبدء معركة إسقاط النظام عسكريا.
وأكد “اسماعيل” أن ضحايا المجزرة الـ 41 بمعظمهم من سكان حي “التضامن” أو من المناطق المحيطة ممن تم اعتقالهم من حاجز مخيم “اليرموك”، الذي كان يفصل بينه وبين حي “الميدان”، وكان الناس بعد سيطرة المقاومة على المخيم في كانون الأول/ديسمبر/2012 يضطرون للخروج بالمئات يوميا نحو دمشق لتأمين حاجياتهم بعد حصار جزئي على المنطقة، ثم يعودون قبل المغرب، مع إغلاق الحاجز مساء من قبل النظام، ومنهم من كان يهرب من الحصار دون عودة.
واستعاد المصدر أجواء عملية الخروج التي كانت خطيرة ومرعبة وعاشها لمرة أولى وأخيرة، حيث كانت تتخللها حالات قنص للمارة المضطرين إلى التوجه من ساحة “الريجة” نحو شارع “اليرموك” الرئيسي وصولا إلى الحاجز، مسافة قدرها حوالي 400 –600 مترا، في أي سنتيمتر منها يمكن أن يسقط شهيدا، كانت مكشوفة لقناصي النظام الذي كانوا يتسلّون في كثير من الأحيان باستهداف المدنيين، ما أوقع عددا من الشهداء، ثم بعد وصول الأهالي إلى الحاجز يخضعون لعملية تفتيش دقيقة اشتدت بمرور الوقت، وهناك اختفى العشرات وربما المئات من المدنيين دون أن يعرف مصيرهم -عدا المحظوظين منهم-، وهناك في الغالب اختار الشبيح “أمجد اليوسف” قائمة ضحاياه العشوائية، ليتسلى هو الآخر بهم في سبيل الانتقام والتشفّي من أبرياء عزّل.
*استراتيجية إبادة
ولفت “اسماعيل” إلى أن المنطقة المحيطة بحاجز قوات النظام كالثقب الأسود، فهي تمتد من منطقة بنايات القاعة، مسجد “الماجد، مسجد البشير”، وصولا للفرن الآلي بين “الزاهرة والتضامن”، هذه الخاصرة كانت مرتعا لأقذر شبيحة عرفتهم العاصمة، وهم شبيحة شارع “نسرين”، الذين انتسبوا لعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية أهمها “الدفاع الوطني”، وفرع المنطقة 227 وسُمّوا على اسم شارع “نسرين” في حي “التضامن”، والذي تقطنه غالبية علوية.
وهم من كانوا يسيطرون على الحي بعد خروج المقاومة منه وتحول حي “التضامن” حسب قوله –إلى ثكنة عسكرية آنذاك وتم تقسيمه إلى 15 منطقة عسكرية (غيتو) وبداخله سجن سري وكل قائد مجموعة من شبيحة النظام كان يتصرف بأريحية مطلقة في المنطقة التي يسيطر عليها وإضافة إلى القتال ضد المقاومة السورية كانوا يمارسون كما ورد في تقرير “غارديان” 4 أنواع من العنف: القتل الجماعي الممنهج وإدارة السجون والمعتقلات والاعتداءات الجنسية والاستغلال الاقتصادي وكانوا ينفذون بشكل يومي عمليات اعتقال دون أسباب وإنما هي ضمن استراتيجية إبادة الطرف الآخر التي يمارسها النظام وكل من يشك به بأنه غير مؤيد.
وتابع محدثنا أن أغلب ضحايا مجزرة “التضامن” كانوا من المدنيين يرتدون هنداماً مرتباً، ما يشير إلى أن اعتقالهم لم يكن من فترة طويلة ولم يظهر عليهم أي ملامح تعذيب أو نحول على حالة من يتم اعتقالهم لفترة طويلة وعلى الأغلب تم اعتقالهم في نفس اليوم أو في يوم سابق وسيقوا إلى هذه الحفرة وتم تصفيتهم خلال نصف ساعة وتم حرقهم فيما بعد.
*عمليات تصفية ممنهجة
ومضى محدثنا الذي يعيش في اسطنبول سارداً جوانب من ذكرياته الأليمة عن تلك الفترة التي ارتكبت فيها المجزرة، حيث كان موجودا في حي “التضامن”، ولكن في مناطق المعارضة، ولم يكن غريبا في خضم المناوشات والعمليات القتالية التي تسفر أحيانا عن تحرير قطاعات والتقدم في كتل سكنية، أن تجد جثة لمدني محروقة ومرمية على سطح أحد المباني، أو تدخل كتلة سكنية فتجد جثثا تمت تصفيتها ورميها في مداخل الأبنية، كان شبيحة “نسرين” ينتقمون من المدنيين القلّة الذين تشبّثوا بمنازلهم نتيجة الفقر وقلة الحيلة، عبر عمليات تصفية ممنهجة وإعدام بدم بارد خاصة عند خسارتهم لنقطة عسكرية أو سقوط قتيل في صفوفهم خلال الاشتباكات المسلحة.
وفي ظل الخسائر التي منيت بها قوات النظام حينها نمت في داخل شبيحة النظام رغبة الانتقام من المدنيين، وفي هذه الأجواء ارتكبت أبشع مجزرة شهدتها المناطق الجنوبية من دمشق بعد أن تم سوق الضحايا معصوبي الأعين مكبّلي الأيدي إلى الخلف، لربما ظنّوا أنهم سينقلون إلى أحد الأفرع الأمنية، ودعوا الله في سرّهم حينها أن يموتوا قبل ذلك خوفا من المعتقل المتخيّل، لكن الشبيح “أمجد اليوسف” الذي قُتل شقيقه في ليلة رأس السنة قبل قرابة أربعة أشهر، كان –كما يقول اسماعيل- يحضّر طقسا من نوع خاص، يوهم فيه المعتقلين أن عليهم الركض للنجاة من رصاص قنّاص، دون أن يدروا أنهم يركضون نحو حتفهم، إلى حفرة أعدّت على عجل لهذه المجزرة، ثم تكدّست بعشرات الجثث، قبل أن تُرصف بإطارات السيارات وتتحضّر لتلقّي أول شعلة نار ستلتهم جثث ضحايا عزّل لا حول لهم ولا قوة إلّا أنهم ظنوا للحظة أن مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تحدث إلا في الأفلام والروايات.
*إعدام بذات الطريقة
وأضاف “اسماعيل” أن المسؤول عن هذه المجزرة بشكل أساسي هو “أمجد يوسف”، وهو صف ضابط وعنصر في فرع المنطقة وكان مسؤولاً عن أمن خط الجبهات وهناك “نجيب الحلبي” أحد سكان حي “التضامن” و”جمال الخطيب” المسؤول المباشر عن المجرم “أمجد”، وهو من أهالي القدم وسجله مليء بالإجرام و”فادي صقر” و”أبو منتجب”، وكلهم يعملون بإمرة اللواء “بسام مرهج الحسن” رئيس أركان “الدفاع الوطني” والعميد “شفيق نصار” رئيس فرع المنطقة في عام 2013، مشيراً إلى أن معظم ضحايا المجزرة من أهالي حي “التضامن” والمناطق المحيطة وغالبيتهم من الشبان والرجال، وهناك بعض الأطفال و7 سيدات 6 منهن محجبات وغالب الضحايا من سنة المنطقة، ولكن هناك أيضاً من يتبعون الطائفة الاسماعيلية، وقد يكون هناك علوية ممكن كانوا يسكنون في المنطقة وشك النظام في ولائهم.
ولفت “اسماعيل” إلى أن المقطع الذي تم تسريبه يصور مقتل 41 ضحية ولكن مجموع المقاطع 27 مقطعا ترصد 288 ضحية استشهدوا في عام 2013 تم تنفيذ الإعدام بهم بنفس الطريقة وذات المكان ومن ثم دفنهم وحرقهم في هذه الحفرة.
وأشار محدثنا إلى أن قوات النظام ارتكبت مجازر أخرى لا تقل دموية عن مجزرة “التضامن” في الربع الأخير من عام 2012، ولديه كما يقول فيديوهات عن عمليات إعدام وتصفية بحق المدنيين وبعضهم تم قتلهم في بيوتهم بعد انسحاب المقاومة من حي “التضامن” أي بعد معركة دمشق الأولى وحينها -كما يروي المصدر- دخل إلى حي “التضامن” وصور تقريراً بث في قناة “الجزيرة” وأثنائها صور كما يقول مقبرة لضحايا تم إعدامهم بنفس الطريقة وقام الأهالي بدفنهم في حديقة صغيرة داخل الحي.
——————————-
====================
تحديث 03 أيار 2022
——————–
أيمن عبدالنور لقناة الحدث: #مجزرة_التضامن تصدم العالم ومطالب بمحاسبة نظام الأسد
———————–
أمجد يوسف ونجيب الحلبي ليسا وحدهما… روايات توثّق القتلة من التضامن إلى الحراك وصيدنايا/ عاصم الزعبي
كانت المشاهد التي ظهر فيها اثنان من جلادي رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمجد يوسف ونجيب الحلبي، في حي التضامن جنوب دمشق، كفيلةً بأن يستعيد السوريون ذاكرتهم القريبة، ليعيشوا مجدداً عشرات المجازر، وتذكّر مجرمين مرّوا في حياتهم طوال سنوات وساقوا آلاف المدنيين نحو حتفهم من دون أن يجدوا من يوقفهم، على الرغم من اتفاق العالم المزعوم وإجماعه على أن ما يجري في سوريا جرائم غير مسبوقة.
لا أحد يعلم إن كان تاريخ نشر “الغارديان” البريطانية لتقريرها الجديد، والذي قام به باحثان سوريان، في نيسان/ أبريل الحالي، والمتضمن مشاهد مصورةً لأحد ضباط أمن نظام الأسد وهو يقتاد 41 مدنياً بينهم نساء، ليعدمهم ثم يقوم بإحراق جثثهم مصادفةً، فالجريمة نفسها وقعت في نيسان/ أبريل من العام 2013، على يد عناصر الفرع 227، “فرع المنطقة”، التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، بعد قيامهم بعزل حي التضامن جنوب دمشق، وتنفيذ عملية إعدام جماعي وحرق جثث الضحايا في حفرة أُعدت مسبقاً لذلك.
حي التضامن
من المهم التعرف على حي التضامن، الذي يوصف بأنه سوريا المصغرة، فهو يقع جنوب دمشق ويفصل بين مخيم اليرموك ومدينة دمشق، وتسكنه مكونات عرقية ودينية مختلفة، كانت السبب بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، في إفراز مواقف متباينة بين أبنائه، منهم من وقفوا في صف الثورة، وقسم آخر قام بتشكيل ميليشيات مسلحة تابعة للنظام لقمع الثوار.
وفي مطلع 2012، قام النظام بإلحاق مختلف ميليشيات الشبيحة في سوريا به بشكل رسمي تحت مسمّى “قوات الدفاع الوطني”، ومُنحت هذه المجموعات صلاحيات كبيرة في إقامة الحواجز ونقاط التفتيش، وتنفيذ عمليات اعتقال وقتل خارج نطاق القانون.
كانت مجزرة التضامن التي وقعت في نيسان/ أبريل 2013، لتكون مخفيةً حتى الآن، لولا الصدفة التي شاءت أن يحصل أحد عناصر الأمن على أشرطة مصورة تبيّن المجزرة، واستطاع بعد هروبه في رحلة استمرت لنحو ثلاث سنوات، أن يوصلها إلى ناشطَين في فرنسا، استطاعا بالتعاون مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، توثيق الجريمة بشكل كامل ودقيق، وباعتراف صريح من مرتكبها الرئيسي.
بتاريخ 16 نيسان/ أبريل 2013، قام كل من أمجد يوسف ونجيب الحلبي، بإعدام 41 مدنياً عبر إلقائهم في حفرة كبيرة تُظهر المشاهد أنها أُعدت مسبقاً، وفُرشت أرضها بإطارات السيارات، ثم تم إطلاق النار عليها تباعاً، بعدها أُحرقت جثثهم.
نُفّذت المجزرة في يوم واحد، وبشكل وصفه التقرير بأنه اعتيادي، من دون أن يكون هناك أي تعاطف من منفذيها مع الضحايا الذين استغاث بعضهم بعد سقوطهم في الحفرة، كما لم تُسمَع من مرتكبي المجزرة سوى كلمات مثل “قوم وطلاع وإمشي وأركض”، في إيحاء للضحايا معصوبي الأعين بأنهم يمرون من منطقة فيها أحد القناصين، لم يكونوا مدركين أنهم يساقون إلى حتفهم حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم.
كما توضح مشاهد المجزرة، أن مدة اعتقال الضحايا قبل إعدامهم كانت قصيرةً، وذلك من خلال لباسهم المدني الذي لم يكن متّسخاً ما يدلّ على اعتقال معظمهم من منازلهم أو على الحواجز، كما لم تظهر عليهم آثار تعذيب، أو هزال في الجسم، كما اعتاد أن يظهر المعتقلون في مراكز احتجاز النظام.
لم تقتصر الضحايا على الرجال، بل كان من ضمنهم سبع نساء، ست منهن يرتدين الحجاب واللباس الذي يدل على أنهن مسلمات، حسب التقرير، ولم تشفع استغاثة بعضهن لدى القاتل الذي نعتهن بألفاظ قبيحة للغاية قبل أن يطلق عليهن النار.
استطاع الناشطون الذين حصلوا على مشاهد الفيديو، ومن بينهم الناشطة أنصار شحود، استدراج المسؤول عن المجزرة أمجد يوسف، من خلال انتحال شخصية فتاة موالية للنظام عبر حساب فيسبوك، واعترف بعد محادثات استمرت لأشهر بقتل الكثير من الأشخاص، إذ قال في إحدى المحادثات: “لقد انتقمت. أنا لا أكذب عليكِ. لقد انتقمت. لقد قتلت. لقد قتلت كثيراً. قتلت كثيراً، ولا أعرف عدد الأشخاص الذين قتلتهم”، وأضاف في تعليقه على فيديو مجزرة التضامن: “أنا فخور باللي عملته”.
جزّارو التضامن
أمجد يوسف، قائد المجزرة، من مواليد 1986، في قرية نبع الطيب التابعة لمنطقة الغاب في وسط غرب سوريا، تربّى على معتقد والده، أحد أهم شيوخ الطائفة العلوية في سوريا، والتحق بمدرسة المخابرات العسكرية في منطقة ميسلون في 2004، وخضع لدورة مدتها تسعة أشهر، ليلتحق بعدها كمحقق بفرع المنطقة رقم “227”، التابع لشعبة المخابرات العسكرية والمسؤول عن دمشق وريفها. وبعد انطلاق الثورة، تم تعيينه مسؤولاً عن قيادة العمليات العسكرية وخطوط الجبهات في جنوب دمشق بين عامي 2011 و2021، في منطقتَي التضامن واليرموك.
نجيب الحلبي، وهو شريك أمجد يوسف في المجزرة، من سكان حي التضامن، ويُعرف بـ”أبو وليم”، وهو ابن لعائلة درزية نازحة من الجولان المحتل، كان مديراً لأحد الملاهي الليلية في حي باب شرقي قبل 2011، وهو أول من أنشأ ميليشيا مسلحة، “شبيحة”، في التضامن، وتُعدّ خبرته في حفر الخنادق والأنفاق سبباً لتزكيته أمام القيادة الأمنية في المنطقة، وسبباً لاستدعائه للمشاركة في الإعدامات الميدانية. قُتل نجيب في العام 2015، في أثتاء حفر أحد الخنادق على جبهة التضامن، من دون أن يتم تحديد كيف قُتل أو الجهة التي قامت بقتله.
وبالإضافة إلى يوسف والحلبي، هناك قتلة آخرون في التضامن لم يظهروا في المجزرة، لكنهم ارتكبوا جرائم لا تقلّ بشاعةً عنها، أبرزهم، فادي أحمد المعروف بـ”فادي صقر”، والذي كان مسجوناً قبل الثورة، وقيل إنه قتل أحد المسجونين معه، ليخرج بعد انطلاق الثورة بعفو رئاسي خاص، بسبب خبرته الإجرامية، وأسس مجموعةً من الشبيحة وشوهد مرات عدة يهاجم المتظاهرين بنفسه بالسلاح الأبيض، كما ظهر برفقة بشار الأسد أكثر من مرة في ريف دمشق.
وهناك صالح الراس، الملقب بـ”أبو منتجب”، من حي التضامن، وهو في العقد الخامس من عمره، أُطلق عليه لقب “هتلر سوريا”، إذ استطاع بث الرعب في التضامن والمناطق المحيطة به، وهو متّهم بالعديد من جرائم الاغتصاب، بحسب التقرير الذي أعدته صحيفة الجمهورية حول المجزرة.
لم تكن هذه المجموعة هي الوحيدة، فعلى مساحة الأرض السورية انتشرت مجموعات مماثلة مارست أشد أنواع الإجرام بحق المدنيين خاصةً خلال عمليات الاقتحام والمداهمة.
مجزرة الحراك
بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2012، اقتحمت قوات الكتيبة 159 ميكا التابعة للواء 52 الموجود قرب مدينة الحراك، المدينة، إذ صادف يوم الاقتحام أول أيام عيد الفطر، وشن عناصر الكتيبة، يرافقهم عناصر من الأمن العسكري حملة دهم وتفتيش واسعة، تخلّلها ارتكاب مجزرة في المدينة، استمرت على مدى أربعة أيام، استخدم فيها عناصر النظام أساليب بشعةً.
ويُعدّ كلّ من العقيد الركن مالك كامل ضرغام، والنقيب غدير معلا من الكتيبة نفسها، والملازم أول رامي مهنا، وهو من ضباط هذه الكتيبة، المسؤولين المباشرين عن المجزرة، والتي رواها شهود عيان، وتم الحصول على المعلومات منهم بطريقة خاصة، مع الاحتفاظ بأسمائهم سريةً للحفاظ على أمانهم.
بحسب الشاهد (س)، من أهالي مدينة الحراك، والذي كان ممن تم اعتقالهم خلال الاقتحام، وكان شاهداً على هذه الجرائم، خلال اقتياده مع معتقلين آخرين ضمن المدينة، فإن مالك ضرغام هو الرجل الأول في اللواء 52 المسؤول عن قتل المدنيين وقمعهم، وهو المسؤول عن الحواجز التي كانت متمركزةً في بلدة الحراك، والتي كانت مركز اعتقال وتعذيب ويساعده في ذلك كل من النقيب غدير معلا والملازم أول رامي مهنا.
ويروي (س)، أنه شاهد عناصر العقيد مالك ضرغام، وهم يعتقلون ثلاثة شبان من الحي الذي يسكنه، وتم إعدامهم رمياً بالرصاص بعد أن اقتادوهم وهم مكبّلين ومعصوبي الأعين إلى الحي الشرقي من المدينة، بجانب محل تجاري بالقرب من طريق المليحة الشرقية، وتم إعدامهم هناك، وهم: عبد الكريم محمود قداح ويعمل صيدلانياً، وشادي محمود قداح، ومحمد محمود قداح، وهم أشقاء، ويضيف أن “ضرغام لم يكتفِ بهؤلاء الثلاثة، بل قام بمساعدة غدير معلا، بإحراق كل من، الشيخ عبد المنعم عبد المولى قداح، والطفل ناصر القداح، بالإضافة إلى قنص كل من الشاب محمد وليد كسابرة والطفل إبراهيم محمد القداح”.
ويضيف الشاهد (س)، أنه “في اليوم الثاني من الاقتحام، قام غدير معلا، بحرق الشيخ عبدو عليوي قومان، البالغ من العمر 90 عاماً في منزله حيث قام بسكب مادة البنزين عليه وأشعله حياً، كما أقدم على قتل كل من ناصر يونس الحريري، وباسل يونس الحريري نحراً بالسكين، وأقدم على تقطيع أوصالهم في الاقتحام عينه والتمثيل بجثثهم”.
كما قام معلا، بذبح طفلين شقيقين لا يتجاوزان من العمر 10 سنوات، وهما أحمد مصطفى حمادي، ومحمد مصطفى حمادي، وحاولت والدة الطفلين التوسل لمعلا كي يترك الأطفال، إلا أنه لم يستجب لها، وقام بقتلهما أمامها.
وأضاف الشاهد، أن “كلاً من غدير معلا، ورامي مهنا، قاموا باعتقال مجموعة من الشبان واصطحابهم إلى محل أدوات منزلية ويحمل هذا المحل اسم “البلخي للأدوات المنزلية”، وقاما بإعدامهم بالرصاص، وهم: حسن علي الزعبي، ومحمد علي الزعبي، وخالد علي الزعبي، وعبد الرزاق علي الزعبي، وبشار صالح الزعبي، وأحمد صالح الزعبي، مشيراً إلى أن هذه الجريمة وقعت في حي الجامع الكبير الذي كان المكان الرئيسي للمظاهرات في بدايات الثورة.
تنكيل وإعدامات
وفي السياق نفسه، وخلال الاقتحام، قام العقيد ضرغام يرافقه الملازم رامي مهنا، بمداهمة منزل خالد محمد حسين أبو صافي، حيث قام مهنا بأمر من ضرغام بإعدام أبو صافي ميدانياً، بإطلاق ثلاث رصاصات على رأسه، أمام زوجته وأطفاله الصغار، كما قام بحبس كل أفراد العائلة في غرفة من غرف منزلهم تطل على الشارع العام، وقام بتوجيه عربة “بي إم بي”، وتم إطلاق قذيفتين لكن الإصابة لم تكن دقيقةً وأصيبت الأم والأطفال الستة بشظايا.
لم يترك ضرغام ومن معه حتى الكبار في السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، فخلال الاقتحام، دخل ضرغام إلى منزل عبد المجيد مرعي أبو صافي، والبالغ من العمر 80 عاماً، وأطلق رصاصات عدة على قدميه وساقيه، ولم يتمكن أحد من إسعافه ما أدى إلى وفاته في اليوم التالي نتيجة النزف، كما قام ضرغام باعتقال كل من راكان عبد الله الزعبي البالغ من العمر أربعين عاماً، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطفله محمود البالغ من العمر 11 عاماً، إذ قام بإحراق الطفل حياً أمام والده، وبعدها أقدم مالك ضرغام على كسر رأس الأب راكان بالساطور إلى نصفين، وقام بقية العناصر بتقطيع جثته إلى قطع عدة تم جمعها لاحقاً ودفنها.
وخلال الاقتحام، كانت النساء هدفاً للقنص من قبل مجموعة العقيد ضرغام، وخاصةً رامي مهنا، الذي قام بقنص العديد من النساء، ومنهن مها الحريري، وهي أم لسبعة أولاد ما أدى إلى موتها.
الشاهد (ع)، من مدينة الحراك، وكان شاهداً على بعض الجرائم خلال تخفّيه في المدينة، يروي أن اثنين من جيرانه، خلال الاقتحام، وهما أحمد الكسابرة 60 عاماً، وابنه ثابت، في العقد الثالث من العمر، خرجا في اليوم الثاني من الاقتحام من أحد الأقبية التي كانا يختبئان فيها، وذهبا إلى منزلهما ليريا ما حل به، وفوجئا بوجود العقيد ضرغام الذي قال لهما بلهجته: “جيتوا ولّا الهوى رماكم”، فأمر عناصره بتكبيلهما وعصب أعينهما، ثم تم اقتيادهما إلى محل تجاري بجانب المنزل تعود ملكيته لسيدة تُدعى أم علي أبو سالم، وقام العناصر بسكب مادة البنزين عليهما وحرقهما حيَّين، ولاحقاً، تمّ التعرف إلى بقايا جثتيهما من خلال بعض أسنان أحمد كسابرة “المعدنية”.
والأطفال أيضاً
رواية أخرى، لشاهد ثالث من مدينة الحراك، كان مُحتجزاً في إحدى السيارات التابعة للكتيبة، يتحدث فيها عن قيام رامي مهنا باعتقال الطفل رسلان إسماعيل التركماني خلال وجوده مع أمه، وقام مع عناصره بذبحه أمام والدته، في الطريق بجانب الجامع الكبير في المدينة.
كما قام عناصر الكتيبة، باعتقال كل من الشقيقين، عبد الناصر موسى القداح، وحافظ موسى القداح من منزلهما الذي يأوي والدتهما المسنة، وقاموا بذبحهما ثم حرق جثتيهما، كما قاموا بذبح المسن صبري نزال القداح وعمره نحو 80 سنةً داخل منزله.
لاحقاً تم نقل هؤلاء الضباط من اللواء 52 في مدينة الحراك إلى مناطق أخرى، وهو أسلوب اعتمده النظام بنقل الضباط خاصةً من عُرف عنهم ارتكاب مجازر في مناطق معيّنة إلى قطع عسكرية أخرى، وغالباً ما تكون بعيدةً عن الأماكن التي عملوا فيها.
لم تكن مجزرتا، التضامن والحراك، هما الوحيدتان اللتان نُفّذتا بطريقة بشعة، فهناك العديد من المجازر التي نفذها ضباط النظام وقادة ميليشياته وحتى ميليشيات تابعة لإيران وعلى رأسها حزب الله اللبناني، كان أيضاً من أبرزها مجزرة بانياس في العام 2013، والتي ارتُكبت بتحريض وتنفيذ من معراج أورال، والذي ينحدر من أصل تركي، ومن الموالين لنظام الأسد، والتي راح ضحيتها عشرات السوريين قتلاً، بإطلاق النار من قرب، وباستخدام حراب البنادق، وأُطلق عليه لقب جزار بانياس على إثر تلك المجزرة.
صيدنايا ومجازر المعتقلين
في نهاية العام 2018، نشرت صحيفة الواشنطن بوست، تحقيقاً أظهر ازدياداً كبيراً في وتيرة الموت في سجن صيدنايا، الذي عدّه التحقيق أسوأ سجن في العالم، وتحدث عن عمليات إعدام يتم تنفيذها على نطاق واسع في السجن، بحسب معتقلين، حيث تبدأ جولات السجانين أيام الثلاثاء للمناداة على أسماء المعتقلين المدوّنة في قوائم الموت، فتطرق أبواب المهاجع المعدنية ويتم الصراخ على المعتقلين للالتفات بوجوههم نحو الجدار، ليتم سحب كل معتقل سيتم إعدامه.
وتحدث التقرير حينها عن أن نظام الأسد كان يسرّع في تلك الفترة وتيرة عمليات الإعدام في سجن صيدنايا، بالاعتماد على قضاة عسكريين، إذ لم يكتفِ النظام بالمعتقلين الموجودين في السجن نفسه، بل كان ينقل معتقلين من جميع أنحاء سوريا إلى سجن صيدنايا، بحيث تُعقَد لهم محاكمات في أقبية السجن، وتتم تصفيتهم قبل الفجر.
وأشار التحقيق، إلى تضاؤل عدد المعتقلين، في تلك الفترة، في السجن الذي كان يتراوح عدد المعتقلين فيه ما بين عشرة وعشرين ألف معتقل، بسبب عمليات الإعدام التي لم تتوقف، حتى أن قسماً واحداً على الأقل من السجن أصبح خاوياً بالكامل بسبب تصفية المعتقلين فيه.
كما لفت إلى دور المحكمة الميدانية في فرع الشرطة العسكرية في دمشق، والتي ازداد فيها معدل أحكام الإعدام، إذ يروي أحد المفرج عنهم أنه حكم في جلسة واحدة على جميع المعتقلين الموجودين بالإعدام، وكانت الأحكام تُتلى بصوت مرتفع.
وبيّن التحقيق، أن العديد من المعتقلين كانوا يموتون قبل الوصول إلى حبل المشنقة، بسبب سوء التغذية، أو الإهمال الطبي، أو الاعتداء الجسدي، مشيراً إلى حالتين على الأقل لمعتقلَين اثنَين أحدهما قُتل بأنبوب معدني أُدخل في فمه، والآخر أجبر السجانون المعتقلين على ركله بأرجلهم حتى الموت، بالإضافة إلى حالات موت نتيجة الانهيار العصبي.
وأكد التحقيق، أن عشرات الجثث المتراكمة، ظهرت في صور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية في الأول والرابع من شهر آذار/ مارس 2017، في باحات سجن صيدنايا، لمعتقلين تمت تصفيتهم ورمي جثثهم في ساحة السجن الأبيض المخصص لاحتجاز العسكريين.
وحول سجن صيدنايا، قال المعتقل السابق في هذا السجن، محمد منير الفقير، لرصيف22، إن “مجازر النظام لم تكن تُرتكَب في الخارج وفي حق المتظاهرين فقط، بل كان للمعتقلين نصيب وافر منها، فخلال إدارة العميد محمود معتوق للسجن في العام 2013، ارتُكبت أبشع الجرائم في حقهم”.
وأضاف: “في العام 2013، بدأنا خلال اعتقالنا، نشتمّ روائح احتراق غريبة ونحن في المهجع، كما بدأت حشرات غريبة بالظهور، وبعد خروجي أخبروني بأنه في التاريخ نفسه أُشيع أن السجن تعرّض لحريق وقُتل فيه العديد من المعتقلين، ولاحقاً تم التأكد من أن إدارة السجن كانت قد أنشأت محرقةً لحرق جثث المعتقلين”.
تنويع الأساليب
يروي الفقير من خلال مشاهداته، بعض الأساليب التي يمارسها عناصر الشرطة العسكرية والتي أدت إلى وفاة معتقلين، ففي بداية اعتقاله في سجن صيدنايا، يقول: “كان معنا شاب اسمه ع.ش، مات في السجن وكان وزنه نحو 180 كغ، ولكن جسمه رياضي، وكان ضخم الجثة لم يدخله العناصر إلى الزنزانة وأبقوه في الخارج عارياً، وصاروا يركبون عليه تشبّهاً بالحمار، ويجعلونه يمشي على أربع، وهم يركبون على ظهره ويضربونه على مؤخرته ومشوا فيه بين كل الزنزانات، “ع” كانت لديه شهامة وعزة نفس وهذا ما جعله لاحقاً ينهار نفسياً، ومات بعد فترة نتيجة الإذلال والتعذيب إذ انخفض وزنه بشكل كبير، وازدادت نبضات قلبه وتأزمت حالته في الزنزانة فأخذوه إلى المشفى وأعادوه إلى المهجع ومات فيه”.
توزيع الطعام ارتبط بموت العديد من المعتقلين في السجن، فحين يوزَّع الطعام يتم إخراج القصعة من فتحة أسفل الباب تُعرف بالشراقة، وعند وضع الطعام تُسحب بسرعة. كان الطعام يأتي فيتم إخراج القصعة من تلك الفتحة ليضعوا فيها الطعام. كانت الكمية قليلةً جداً أي نحو ملعقة من الأرز و حبات عدة من الزيتون رائحتها مازوت، ونحو ملعقة من المربّى، وربع حبة من البطاطا أو نصف بيضة، ويُفترض أن يكون المعتقلون جاهزين عند توزيع الطعام بحيث تُسحَب القصعة فوراً عند وضع الطعام ويتم إدخاله بسرعة وكانت كمية الطعام هذه لمدة 24 ساعةً، وكان من يتأخر في سحب القصعة يعاقَب، فمن الممكن أن يقول له العنصر مدّ يدك فيضربه عليها، أو يدوس عليها، أو أن يجعله يمدّ رأسه ليدوس عليه أو يضربه بالأنبوب الأخضر على رأسه، وقد مات معتقلون عدة نتيجة هذه الضربة، أو كان السجان يقوم بإغلاق الباب الحديدي على رأس المعتقل، بحسب الفقير.
يضيف: “في الشتاء كانت طريقة السجانين في العقوبات تتغير في سجن صيدنايا، فالضرب يخفّ ولكن تتم الاستعاضة عنه بالعقوبات بالماء البارد. في إحدى الليالي جعلوا المعتقلين يخلعون ثيابهم، وفتحوا أبواب الزنزانات وأغرقوها بالماء البارد وبقي الماء في الزنزانات لمدة يومين، ولم يسمحوا بتصريف المياه حتى مات من كل زنزانة معتقل أو اثنان. كانت هذه العقوبة لكل زنزانة يُسمَع فيها أي همس إذ يغرقونها بالماء حتى يموت فيها معتقل على الأقل”.
القتل وإعدامات المشفى
يُكمل الفقير روايته، أو بعضاً من رواياته الكثيرة حول ما عاشه وشهده في صيدنايا، ويقول: “قبل ترحيلنا بأيام عدة من الفرع 291، التابع للأمن العسكري، أصبح الطعام قليلاً جداً، لذا قررنا أن نرفض تناول الطعام المقدَّم إلينا وفعلاً حين قدموا لنا الطعام قلنا لهم إننا لن نأكل، فجاء مساعد وكان قاسياً، وسأل من منكم لا يريد الطعام فقلنا جمبعنا، فقال: أريد شخصاً واحداً يكلّمني وعليه الأمان، فوقفت أنا واثنان معي وقلنا له نحن لا نريد تناول الطعام فهو قليل ولا يكفي فقال لنا هكذا أنتم تقومون بالتمرّد على الدولة، وسيعاقبكم القانون”.
حينها، وقف فقير وقال: “إذا أردت الكلام عن القانون أنا موجود هنا منذ 120 يوماً، وأهلي لا يعرفون أين أنا، والقانون يقول إنه يحق لي التزام الصمت حتى يحضر معي محامٍ ويجب أن يعرف أهلي أين أنا موجود، ويجب أن أخضع لمحاكمة بعد أيام من اعتقالي، وأنا حتى الآن مختفٍ وفي حالة انقطاع عن العالم الخارجي. فقال لي عن أي قانون تتكلم؟ أنت هنا بمعرفة القاضي، وهو من يقوم بتمديد اعتقالك، فقلت له أنا لم أرَ أي قاضٍ وأريد رؤيته، فقال لي نحن بكل بساطة الآن نستطيع قتلكم جميعاً هنا، ونرميكم في أقرب حاوية نفايات، ونقول إن مسلحين إرهابيين قتلوكم”.
في مشفى 601 في المزة، يُكمل فقير، كانت هناك حالات إعدام في الليل إذ يسحبون المعتقلين ويعدمونهم خصوصاً من عنبر الأمن العسكري. كنا نرى خيالاتهم وهم يضربون المعتقلين من خلف الزجاج المحجّر المطلّ على بهو العنابر، وفي الصباح نشاهد جثث المعتقلين الذي قُتلوا ممدةً في الحمام، وبعضهم كان من عناصر السخرة وكنا نعرفهم. وحين سألنا بقية عناصر السخرة عنهم وأين يذهبون بجثثهم؟ قالوا لنا إنهم يأخذونها إلى كراج تحت المشفى، وكان هو الكراج الذي ظهر لاحقاً في صور قيصر المسربة”.
حتى الآن لا يمكن إحصاء كل المجازر التي ارتكبتها أجهزة النظام الأمنية، وقواته العسكرية، فمعظمها لا يزال مخفياً، وما تم توثيقه هو ما ظهر منها إلى العلن فقط.
فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق ما لا يقل عن 50 مجزرةً نُفذت بشكل طائفي في الفترة ما بين آذار/ مارس 2011، و15 آب/ أغسطس 2018، كانت حصيلة ضحاياها ما لا يقل عن 3،098 شخصاً، يتوزعون كالتالي: 3،028 مدنياً بينهم 531 طفلاً، و472 سيدةً بالغةً، و70 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
وتوزعت هذه المجازر بحسب المحافظات كالتالي:
حمص: 22 مجزرةً راح ضحيتها 1،040 شخصاً.
حلب: 8 مجازر راح ضحيتها 416 شخصاً.
حماه: 8 مجازر راح ضحيتها 197 شخصاً.
ريف دمشق: 5 مجازر راح ضحيتها 686 شخصاً.
طرطوس: مجزرتان راح ضحيتهما 473 شخصاً.
إدلب: مجزرتان راح ضحيتهما 35 شخصاً.
درعا: مجزرتان راح ضحيتهما 59 شخصاً.
دير الزور: مجزرة واحدة في حيَّي القصور والجورة، راح ضحيتها 192 شخصاً.
تشير كل المعلومات، إلى أن هناك العشرات من المجازر التي لا تزال مخفيةً حتى الآن، وربما تحتاج إلى سنوات لاكتشافها، فمجزرة التضامن لم تكن لتكتَشف لولا الصدفة، ومن الناحية العملية لن يُكتَشف كل شيء إلا بعد حدوث انتقال سياسي كامل في سوريا يتيح للجان التفتيش الأممية البحث في المجازر والمقابر الجماعية التي لم تتسرب معلومات حتى الآن سوى عن عدد بسيط منها، وإلى ذلك الحين هناك كُثر ينتظرون خبراً عن قريب أو عزيز، وهم اليوم يعيدون مشاهدة فيديوهات حي التضامن، ويدققون في الوجوه، ويغرقون في حزنهم، لا أكثر.
رصيف 22
————————
كاميرات القتلة .. توثيق الولاء/ سميرة المسالمة
لم أصرُخ ولم أعترض. ببساطةٍ تقبلت الأمر. كان عليّ أن أستقبل الموت القادم من بنادقهم بهدوء. لم أرغب أن أزعج ملاك الموت بضجيج الحياة، هكذا كان كلّ شيء حولي غائباً، صراخ أبي وبكائي لم يكونا ليغيّرا أي معادلة، وأنا استسلمت، كان الفراغ يحتضنني، فقط بعض شتائمهم كانت تؤلم روحي التي هي على وشك الرحيل، تذكّرت أنّني أريد أن أقول لهم شيئاً: “لا تخبروا أمي كيف قتلتموني”.
تلك وصية مجد، ابني الذي نجا منهم. هو ليس وحده من كان لا يريد أن يكون موته معلناً بتفاصيله. قولوا لها إنّه رحل، لماذا وكيف وإلى أين ليس مهماً. التفاصيل تتحوّل أحياناً إلى أدوات تعذيب لأحبتنا، هذا ما كان ابني يدركه وهو يجرّ إلى خاتمةٍ لمعنى “الحياة في دمشق” التي يزاود بعضهم علينا بترديدها. نجا ابني من آخر مشهد مكرّر لفيديوهات القتل في سورية، ويبقى سؤالي: هل حقاً قد نجا؟
تعيدني مقاطع الفيديو التي نشرتها صحيفة الغارديان اللندنية إلى مشهد حضرته في مكتب المسؤول الأمني للقصر الجمهوري، خلال تحقيقه معي في الشهر الخامس من عام 2011، عندما رفع في وجهي “شريطاً مصوّراً”، وقال: “لقد صوّرنا كيف انقض المتظاهرون على الأسلحة التي تركناها وبدأوا باستخدامها… إنّها نهاية ثورتكم”. كان سعيداً بنجاح الفخّ الذي نصبوه. الكاميرا بيدهم ليست مندسّة، إنّها جزءٌ من المشهد العام للجريمة، وتسريبات كثيرة مصوّرة لم تكن مصادفة عابرة، أو حتى عملاً مضادّاً بغاية تعريتهم. إنّها سلاحهم الحادّ، سلاح الترهيب، إعلان مموّلٌ بدماء السوريين عن نوع بشري “متحوّل” لا ينتمي إلى أي دين أو طائفة. إنّه ببساطة مدرسة الأمن السوري، وفقط، بكلّ من ينتسب لها على اختلاف خلفياتهم القومية والدينية والمذهبية.
الفيديوهات القاتلة ليست مسرّبة من هاتف عنصر أمن صوّر الجريمة لهول فظاعتها، إنّها بعض من أرشيف كامل للأمن السوري عايش تطور التكنولوجيا وأساليب التجسّس على السوريين منذ تأسيس المكتب الثاني برئاسة عبد الحميد السرّاج، يدرس من خلالها سلوك عناصره ويحدّد درجات ولائهم وقدرتهم على تنمية الوحش الذي زرع داخلهم. لهذا يبدو من المنطقي أن تكون مقاطع الفيديو موجودةً ضمن محتويات داتا أجهزة حواسيبهم، وضمن دروس تأهيل عناصرهم، وسيلة إيضاح وسلاسل قيد يطوّقون بها أعناق المتردّدين ويقيسون على أساسها ولاء المتنطّحين للمناصب الجديدة، فهل أنت مؤهلٌ لتكون جزءاً من هذا النظام؟ افتح عينيك وقلبك واقتل ضميرك ثم اعتلِ الدرج!
ليس الامتحان مرهوناً بعناصر أقل مكانة أو أكثر حظوة، الجميع مرّ من هناك وأمام الكاميرات، من الأسد الأب إلى الأسد الابن، والأرشيف عامر بما لا يمكن توقعه.
حكاية أمجد يوسف (المجرم في فيديوهات “ذا غارديان”) هي حكاية كلّ عنصر أمني يطمح لأن يكون من أهل الثقة لدى نظام الأسد. الجريمة أقصر طرق الوصول إلى الدائرة الموثوقة، في كلّ الجرائم التي تسرّبت مقاطعها، لم يُخف أيٌّ من مرتكبيها وجهه، لم تهزّهم الكاميرا، حرصوا على أن يأخذوا زوايا تثبت أنّهم يرتكبون الجرائم بمتعة، أظهروا قدراً كافياً من الحماسة، كرّروا فعلتهم مع الضحايا، أدركوا في لحظة مناسبة تفوقهم، التفتوا إلى المصوّر وأطلقوا تعليقاتهم الحماسية. لا شيء يدعونا إلى الاستغراب، هو يظهر بوضوح بكامل هيئته ويحرص على تصوير تفاصيل وجهه، ويرسم خطواته بثقة. إنه الجسر الذي يوصلك إلى قصر الرئيس من دون طلب لقاء، أو المرور بوسيط، اضغط زر الإرسال، هناك من ينتظر مشاهدة يوميات جنوده الأوفياء، وقصصهم، ويتعرّف إلى عدد ضحاياه، ليمضي إلى فراشه مثقلاً بأفراح انتصاراته على أعدائه المدنيين الإرهابيين.
لا توجد جرائم في سورية غير موثقة في أرشيف الأجهزة الأمنية، من إعدامات سجن تدمر إلى مجزرة جسر الشغور، ومن حصار درعا إلى مجازر صيدا وكفر عويد والتريمسة والحولة والقبير وزملكا وداريا والبيضا والرستن ورسم النفل ونهر قويق والغوطة وخان شيخون ومخيم اليرموك، بأغلبية ضحاياه الفلسطينيين، إلى مجازر إدلب. ليس هذا التوثيق خشية ضياع مصير الضحايا، لكن لأنّه الطريق إلى فرز الموالين المخلصين للنظام من جهة، ولإمساك ما يدينهم، فلا تسوّل لهم أنفسهم التبرؤ مما ارتكبوه من جهة ثانية. ولتمايز هؤلاء عن ضباط وعناصر آخرين، يشرع بعضهم في ارتكاب جرائمهم كأدوات تنفيذية خاليةٍ من الحماسة والاندفاع، رغم ارتكابهم مجازر القتل، لكنّهم يستطيعون التمييز بين من آمن بالقتل وسيلة لحياة نظامه ومن ينفذه فقط.
كما أنّ لهذه الفيديوهات المصوّرة أو الصور الليزرية أو الفوتوغرافية مهمة أساسية في إمتاع قيادات النظام، وضمان وحشية قواتهم، وإخلاصها لهم في تنفيذ مهمات إبادة معارضيهم وحاضنتهم الشعبية، إذ تبنّى رأس النظام بشار الأسد في خطاباته نظرية الإنسان ابن بيئته، التي برّر فيها قصف قواته مناطق سكنية كاملة تحت اسم بيئة حاضنة للإرهاب، وأنّها أسهمت في صناعة المجتمع المتجانس من قتلة ومؤيدين لهم فقط.
منذ بداية الأحداث، احتكر النظام مشروعية حمل الكاميرات لنفسه، فقد جرّم رأس النظام كلّ من أسهم بالتقاط صورة لمجريات الثورة السورية، وطرق قمعها، من أجهزته الأمنية، واعتبرهم أخطر على الدولة من المتظاهرين أنفسهم، في وقتٍ استخدمت أجهزة الأمن الكاميرات لتكون إحدى وسائل الترهيب وتعريف الناس بمصائرهم المحتملة، وإثبات التهم على المتظاهرين، فإما يصار إلى ابتزازهم لاحقاً أو اقتناصهم، فالسوريون يعيشون حالة من الإثارة الدائمة، حيث أقدارهم كاليانصيب، إما أن يكسبوا الموت بالقتل المباشر، أو تحت أنقاض بيوتهم المقصوفة، أو يتركوا ليموتوا جوعاً وبرداً وحرقاً، أو يخسروا قيمة حياتهم بنطاق صمتٍ تحدّده جغرافية مكان إقامتهم. هذا يانصيب الموت والحياة وجوائز القهر السوري، وتسريبات قديمة وجديدة، فقط، تحدّد لنا خريطة طريق مقابرنا المجهولة.
العربي الجديد
———————-
حين طلب مني عناصر المخابرات السورية أن أطير كـ”غراندايزر”/ نور الدين حوراني
كل مدني شاهدته في مقطع مجزرة التضامن، أعاد علي الألم ذاته، والشعور المرعب ذاته لحظة السقوط في الهواء. وأكد لي المنهجية التي يتم تدريسها لعناصر القتل والإجرام التابعين لنظام الأسد.
ماذا لو قلتُ إنني أرغب في أن أصرخ؟ هل سيكون هذا التصريح على قدرٍ من الأهمية، يدفع أي أحد ليسألني لماذا؟! لا أعتقد ذلك في الحقيقة، لأن هذه الرغبة باتت خلال السنوات الأخيرة مشتركة بين الجميع، وخصوصاً السوريين. والأسباب معروفة ومتعددة. لكن، ماذا لو كان الأكثر ألماً، هو عدم القدرة على الصراخ! أقصد أن يختنق الإنسان بصوته كلما حاول القيام بذلك!
في إحدى السنوات الأخيرة، وتحديداً عام 2016، كنت أجلس مع فتاة أحبها في حديقة “النيربين”، وهي حديقة معروفة في دمشق، تتسلق جبل قاسيون، في أعلى نقطة منه، يمكننا من هناك أن نشاهد المدينة كاملة. وبما أن الطابع العام في سوريا خلال السنوات الأخيرة كان مغمساً بالدم والبارود، لم تكن الأحاديث بين أي عاشقين، تخرج عن إطار الحرب. لذلك، وكما أتذكر، كنا نحاول معاً، أن نحصي عدد المقابر التي تمكننا مشاهدتها من تلك الحديقة. كنا نشير إليها واحدة واحدة بأصابع الخوف. فتلك مثلاً “مقبرة الشيخ رسلان” وإلى اليسار قليلاً “مقبرة الدحداح” وفي العمق “مقبرة باب الصغير”. كنا نشير إليها، ونحن نعلم ضمنياً، أن المدينة الممتدة أمامنا، مدينة الياسمين والحارات القديمة، والسبعة آلاف عام. تقوم على مدينة أخرى تمتد تحتها. مدينة المعتقلات والزنازين والأقبية، مدينة ضخمة لتصفية الأرواح، تحت أقدم عاصمة في التاريخ. لكننا لم نكن نعرف، أو نتخيل، أن المقابر التي أشرنا إليها، ليست سوى “مقابر داخل مقبرة كبيرة”، حراسها جنود نظام الأسد وميليشياته.
شرح ما هو مشروح: كمحاولة إطفاء النار بالبنزين
انتشر مقطع فيديو، مصدره صحيفة “الغارديان” البريطانية، يظهر فيه أحد عناصر مخابرات النظام السوري، الذي تم التعرف إلى هويته وهو المدعو أمجد يوسف، وينحدر من إحدى القرى الساحلية، عين الطيب، برفقة عنصر آخر نجيب الحلبي وهو من إحدى قرى جبل الشيخ. كانا يقومان (بمُهمتهما) على حد تعبير المجرم أمجد، المهمة التي تقتضي بارتكاب مجزرة بحق 41 مدنياً من سكان حي التضامن الدمشقي. وذلك من خلال تصفيتهم، الواحد تلو الآخر، بأسلوب بشع، أقرب ما يكون إليه من الوصف “كانهما في واحدة من ألعاب الفيديو” على حد تعبير الصحيفة. وهو التعبير الأكثر دقة برأيي في وصف تلك المجزرة. وبما أنني أحاول قدر المستطاع، أن أبتعد من شرح حيثيات الفيديو وتفاصيله. لما لذلك من آثار مؤلمة، لن تزيد الجراح إلا عمقاً. سأتناول فقط، نقطة واحدة شاهدتها في المقطع، لإسقاطها على حادثة شخصية، بما أنني كنت أحد المعتقلين السابقين، في الفرع الذي كان المجرم أمجد وصديقه نجيب، يخدمان لمصلحته. وهو الفرع 227 التابع لإدارة المخابرات العسكرية. ومقره في كفر سوسة وسط دمشق.
أسلوب القتل والتصفية: منهجية ثابته ومتكررة
في المقطع الذي يصور المجزرة، يظهر المجرم أمجد يوسف، يقتاد المدنيين، معصوبي الأعين، ومكبلي الأيدي وراء الظهر، هم لا يرون شيئاً، ولا يعلمون أين ستدوس أقدامهم في الخطوة التالية. يجبرهم على الوقوف بالقرب من حافة حفرة هائلة أُعدت مُسبقاً. ثم يأمرهم بألفاظ قذرة، بأن يركضوا. لتكون خطوتهم الأولى على الأرض، والتاليه في الهواء. فيسقطون في الحفرة فوق جثث من سبقوهم. لتتم تصفيتهم بالرصاص. سواء أثناء سقوطهم في الهواء، أو بعد أن يرتطموا بالآخرين المكوَمين في قاع الحفرة.
ما أقدم عليه أمجد، يوضح المنهجية الثابتة والمُتبعة من قبل مخابرات النظام وعناصر أمنه، في القتل والتعذيب. فعام 2017 تم اعتقالي على خلفية سياسية من مكان عملي في أحد مطاعم دمشق. اقتادتني الدورية التي جاءت “لشحطي” إلى أحد فروع الأمن، وقد عرفت بعدما خرجت أنني كنت مُعتقلاً في الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية. ويدعى فرع المدينة. عند وصولي إلى هناك، معصوب العينين، مكتوف اليدين وراء الظهر، أشبه تماماً كل الذين رأيتهم في فيديو المجزرة، وقف خلفي أحد العناصر الذين اعتقلوني.
قال بصوته الذي ما زال يرن في رأسي: “بتعرف كيف بطير غريندايزر؟”.
كان سؤاله يشي بأن أمراً سيحدث، وتوقعت أن تكون هذه نهايتي. فهذا الأسلوب الكلامي الذي يتبعونه، ولو كان في ظاهره يحمل روح الدعابة، إلا أن مضمونه عذابٌ، لا يمكن وصفه.
في الحقيقة لم أتمكن من الإجابة، فكل حرف سأنطق به، سيكون سبباً ليقوم ذلك العنصر بضربي أو تعذيبي. برغم أنهم (عناصر مخابرات الأسد) ليسوا بحاجة لأسباب تبرر قيامهم بالقتل أو التعذيب.
اخترت أن أجيبه بعدما ضربني بأخمص بندقيته بين كتفي من الخلف، وقلت: لا والله يا سيدي. ما بعرف.
فضحك بسخرية وقال: أمامك “كريدور طويل” أريد خلال ثلاث عدات أن تركض بأقصى سرعتك، لتصل إلى آخره. فصدقته.
وفعلاً، خطوت أول خطوة على أرض ثابتة، لكن الثانية كانت في الهواء، فتدحرجتُ من أعلى درَجٍ كان ينحدر أمامي، لأرتطم في الأسفل، بجدار عالٍ، وأسفر ذلك عن كسر في كتفي ونزيف من أنفي. بينما أسمع في الأعلى صوت ضحكات عناصر الفرع، وشتائمهم.
كل مدني شاهدته في مقطع مجزرة التضامن، أعاد علي الألم ذاته، والشعور المرعب ذاته لحظة السقوط في الهواء. وأكد لي المنهجية التي يتم تدريسها لعناصر القتل والإجرام التابعين لنظام الأسد.
عندما كنت طفلاً صغيراً، كانت العادات في أيام الأعياد، تقضي بأن نزور المقابر بصحبة الأهل. وأكثر ما كانت تحرص عليه أمي وقتها، هو أن أنتبه جيداً، أثناء عبوري بين القبور. كي لا أدوس ولو بالخطأ على أحدها، حتى إنها كانت تحذرني من الجلوس على النواصي المحيطة بها. متذرعة بأن علينا احترام أرواحهم. لكن الآن، من يخبر أمي أنني كنت دون أن أعلم، خلال السنوات العشر الأخيرة، ومثلي الكثير ممن لم يحالفهم الموت على يد المجرمين، نمشي على مقابر جماعية تحت دمشق؟ دُفنت فيها أجساد أُناسٍ، كانوا يعيشون بيننا. ومن يخبر الآن أيضاً، الفتاة التي كنت أحبها، أن المقابر التي أشرنا إليها ونحن نجلس في الحدائق، كحديث بين عاشقَين، لم تكن سوى ما استطعنا أن نراه فقط؟ من يخبر الناس في دمشق الآن، أن يتوخوا الحذر والانتباه في خطواتهم التالية. فلربما تكون مقبرة جماعية أُخرى، تحت أقدامهم. لم يُكتشف أمرها بعد
في نهاية الأمر، فإنني أتبنى عبارةً ضمنها رسام الكاريكاتير السوري هاني عباس في لوحته التعبيرية عن تلك المجزرة، والتي تحمل رسالة لكل سوري ما زال يشاهد بصمت. يقول فيها على لسان الضحايا “يلي قتلونا غطولنا عيونا وما شفناهم، بس هلأ أنتو شفتو وجوههم منيح”…
درج
———————–
عن سورية التي وقعت في الحفرة/ غازي دحمان
عبثاً يحاول السوريون تجميع شتات هويتهم الوطنية التي تمزّقت، يجهدهم إصرار الأسد على قتل كل إمكانية لإعادة الروح لها، وتصرّ حرب الإبادة، التي ما زالت تمارس بلا كلل، على رفض عمليات التجميل لوجه سورية الوطني الذي مزّقته الحرب، فالندوب أكبر فعلا من إمكانية تقنيات التجميل، مهما بلغت احترافيتها، أو حجم تشبّعها بالنيات الحسنة.
في الحرب التي يشنها نظام الأسد على أشواق السوريين إلى الحرية، وعلى محاولاتهم إعادة صناعة وطنيتهم، بمزيد من العبثية والقتل، تبدو الخيارات ضعيفة، فإما أن تبقى الهوية السورية متشكّلة من الخضوع + الذل + عبادة بيت الأسد، وإما فلا، وإلا لماذا ولمن رفعنا شعار “الأسد أو نحرق البلد”، لا وطنيات خارج هذا التعريف، حتى لو اقتضى الأمر إفناء سورية كلها.
ورغم أن مجزرة حي التضامن ليست سوى تفصيل صغير ضمن ماكينة هائلة من المجازر أكلت أعمار السوريين، إلا أنها كشفت لهم ما كانوا يحاولون إثبات عكسه، وأنهم في ثورتهم استطاعوا ترويض عصابة الإجرام وقهرها، وأن الثمن الذي دفعوه، على الرغم من ضخامته وحجم الألم الذي نتج عنه، لم يكن بلا معنى.
تثبت تفاصيل المجزرة الحقيقة البائسة للأوضاع في سورية، عصابة تأسر ملايين من العزّل، مباحين في كل لحظة للقاتل، وهي من تختار من يقتل وبأي طريقة وأسلوب، من لم يمت إلى الآن فبفضل المصادفة والأقدار، وليس بفضل الثورة وتضحياتها، بل ربما عقاباً لها ولهم.
إذاً لا وطن ولا وطنية، بل المعيار المحدّد هنا هو البندقية، والمعادلة فيها صفرية، إما تقتلني أو أقتلك. لا دستور ولا أنظمة أو قوانين مرعية، ولا حتى أعراف تحكم العلاقة بين المكونات. وما يسمّى “التراث الوطني” الذي جرى الاستناد عليه، أو المراهنة به، حين قيام الثورة جرى شطبه في لحظة، وتشكيل قيم ومعايير “وطنية” جديدة على وقع طبول الحرب.
على ضوء ذلك، ثمّة سؤال ماكر يطرح نفسه متشمتاً: أي غباءٍ كنتم عليه عندما اعتقدتم أنكم تخوضون ثورة وطنية ضد نظام ديكتاتوري، مثل كل خلق الله في هذه الدنيا؟ كيف لم يخطر ببالكم أنكم ستضعون ملايين العزّل في فم الغول، بعد أن تستشهدوا أو يجرى اعتقالكم أو حتى بعد هربكم “نجاتكم من يد القاتل”؟ لماذا اعتقدتم أن العصابة ستفهم اللعبة كما تصوّرتموها، وتحترم بالتالي قوانينها وشروطها، وأنها ستنتهي لصالحكم حكماً ما دامت العدالة والرأي العام العالمي والحق تقف معكم؟
لعل أشدّ ما أحزن أولئك الذين وقفوا مع الثورة وأيدوها بقلوبهم وعقولهم وأجسادهم، حالة اللامبالاة، الفظيعة، التي أظهرها القتلة، وهم يقذفون ضحاياهم بدم بارد في الحفرة، وضعف السوري المنقاد للموت، لماذا لم يصرخوا الصرخة الأخيرة، وهم يهوون إلى الموت؟ هل نسوا أن يفعلوا، أم أنهم اعتقدوا أن الأمر مجرّد مزحة ما دام قتلتهم كانوا يمزحون وهم يجرّونهم إلى حتفهم، أم كانوا ما زالوا يطمعون بالرحمة؟
يعرف السوريون في أعماقهم أن مئات آلاف قتلوا بهذه الطريقة، فالعصابة نشرت آلاف الحواجز، وبجانب كل حاجز هناك مقبرة جماعية دفن فيها عشرات السوريين، كان يجرى إنزالهم من الحافلات، أو وهم عابرون إلى مكان آخر، كان أي عنصر على هذه الحواجز يقرّر مصيرك، مزاجياً أو على الهوية، من حوران أو داريا أو الغوطة أو حمص، بعد أن أسقطت العصابة القانون، وعمّمت على عناصرها أن القتل الكثيف أهم أدوات الانتصار.
المؤكد أنه وقت ارتكاب المجزرة في حي التضامن، لم يكن تنظيم داعش قد ظهر بعد، وبالتالي، لم يكن الفرز الطائفي قد اتضح بعد، علماً أن “داعش” لم تكن له حاضنة في سورية. لذلك ثمّة من يرى أن هذه المجزرة وأخواتها يمكن وضعها في سياق استيلاد “داعش” والتعجيل بظهوره، ليصار إلى شرعنة ألف مجزرة سبقت ومثلها سيأتي.
ومع التأكيد أن الأزمة في سورية ليس لها سبب طائفي، إلا أن العصابة ساقت الأمور بهذا الاتجاه عنوة، دع عنك خطابيها، الإعلامي والدبلوماسي، فذلك ليس سوى مساحيق تجميل لا يمكنها أن تغطّي بشاعة أفعالها الحقيقية، إلا أنها على الأرض صممّت العملية لتكون بهذا الشكل، أوعزت للعلويين بأن هذه حرب وجود ضدهم، وليست شعارات الحرية سوى محاولات للتغطية عن الهدف الحقيقي، وأشعرت السنّة أنهم كلهم مدانون بسبب انتمائهم وهويتهم.
في “التضامن”، سورية كلها باتت واقعة في الحفرة، بكل مكوّناتها وأطيافها، والسؤال اليوم: كيف يمكن إنقاذ الوطنية السورية وتخليصها من ألف مأزقٍ وضعتها بها العصابة في طريقها إلى الحفاظ على السلطة؟ مؤكّد أن لا أحد يملك إجابة شافية الآن، ليس بسبب هول الصدمة وحسب، بل لقصر ذات اليد، لا أحد لديه الوسائل والأدوات للخروج من هذه الحفرة، حتى الإدانة، على بساطتها، لا يملك سوريو الداخل رفاهية فعلها، فكيف الحال بالتعبير عبر تظاهرات تخرج في اللاذقية ودمشق ضد هذه الأعمال؟
الواقع أن الوطنية السورية باتت مجرد أشلاء ممزّقة على قارعة الطرق، أو أحلام في رؤوس الحالمين، متى تجميع قطعها، متى سيصبح ممكناً ترجمتها من الحلم إلى الواقع؟ هذا هو السؤال اليوم.
العربي الجديد
—————————
وأنت أيضاً.. كيف قتلوك على الحاجز؟/ عمر قدور
أمجد يوسف واحد فقط من مجرمي الأسد، هو ليس بين صفوتهم وكبارهم، وحواجز “شبيحة شارع نسرين” في حي التضامن ليست الحواجز الوحيدة التي يمكن وصف وظيفتها بالقول: قِفْ.. حاجز. قفْ.. مجزرة. مصيبة مجزرة التضامن التي كشف عنها التحقيق الذي أعدته الباحثة أنصار شحّود والباحث أوغور أوميت أونغور أنها تؤكد بالدليل الصادم على ما هو معروف نظرياً، وفي أن التحقيق يوثّق جانباً مما يحدث في حواجز الجيش أو المخابرات أو الشبيحة، الجانب المتصل بالإعدامات الجماعية أو الممنهجة التي يُظن أن ارتكابها محصور في أقبية المخابرات وفي السجون.
لدينا المئات، بل الألوف، من أمجد يوسف المرتكب الرئيس لمجزرة التضامن. هو الذي يقرر من يستحق القتل، فيُقدم على إعدامه من دون استشارة مرجعية أعلى، إنه مخوَّل بتنفيذ مجزرته الخاصة كيفما يشاء ضمن التصريح الممنوح له. انضواء أمجد يوسف في المخابرات العسكرية يسهّل إثبات المسؤولية على قادته، وصولاً إلى القائد الأعلى بشار الأسد، لكن كما نعلم للشبيحة “من خارج الجيش والمخابرات” حواجزهم حيث تفنن البعض في التنكيل بمن ساقهم سوء الحظ إلى محاولة العبور منها. لقد وصل الأمر إلى التباري بين الحواجز، فبعد أن شاعت سمعة شبيح يرمي بضحاياه إلى ضباع يجوّعهم سيضارب عليه آخر بجلب أسُود للغرض ذاته. لا مجاز إطلاقاً هنا في الحديث عن ضباع وأسود.
منذ المظاهرات الأولى في آذار 2011، عندما كان عدد المتظاهرين بالعشرات أو المئات، ظهرت الحواجز في كل مكان. كان هذا التدبير مجرباً من قبل، وإنْ على نطاق أقل كثافة، فعندما اندلعت المواجهة مع الإخوان المسلمين راحت الحواجز تنتشر، ثم تزداد بين أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، ليبقى البعض منها راسخاً لسنوات لاحقة رغم القضاء على الإخوان وعلى عشرات ألوف المدنيين في مدينة حماة خاصة.
تعايشَ السوريون مع فكرة الحاجز أيام الثمانينات، ثم بعد اندلاع الثورة، وقبلها عرف اللبنانيون ما يعنيه حاجز المخابرات أو الجيش السوريين. ثمة جهد يستحق أن يُبذل، وأن يشارك فيه سوريون “ولبنانيون أيضاً”، من أجل توثيق التجارب الشخصية، والمنقولة على نحو موثق، مع الحاجز التابع للأسد. الذروة بلا شك ستكون للمجازر الجماعية، نزولاً إلى حالات القتل الفردية والعشوائية، مروراً بحالات التنكيل التي تهدف فقط إلى الإذلال أو التشفي، وصولاً إلى ما يُسرد كطرائف تتعلق غالباً بالمستويين العقلي والأخلاقي المنحطَيْن لعناصر الحاجز. لنا أن نتخيل حصيلة ضخمة جداً ومرعبة من الذكريات مع الحواجز، ويلزم أن نغادر الاعتياد للتفكير في “فقه الحواجز” الأسدي كما عاشه الملايين.
بالحواجز، ينشر الأسد على نطاق واسع إمكانية ممارسة العنف والإرهاب ضد الجميع، بمعنى أن العنف لا يعود محتكراً لفئة قليلة من جلاديه تستهدف فئة محددة من معارضيه. هنا تتوقف المهمة الكلاسيكية للمخابرات “وحتى الجيش”، ليصبح المعارضون، أو فئات منمَّطة مناطقياً أو طائفياً أو عرقياً، مستهدفين في المقام الأول. إلا أن إرهاب الأسد الموسّع أفقياً هو بطبيعته موجه ضد الجميع، أي ضد كل الذين ليسوا مشاركين بدرجة ما في ممارسته، وهو لهذا يحتمل الخسائر الجانبية، بمعنى أن يكون من ضحاياه بعض الموالين.
ينظر القائمون على الحواجز إلى أنفسهم وإلى أقرانهم بوصفهم ممثلين للدولة، أو الدولة نفسها، وينظرون إلى ضحاياهم من تعساء الحظ بوصفهم كائنات ما دون الدولة. نستعيد في هذا السياق مناقشة حنه أرندت لمدلولات وصف هتلر معارضيه بـ”ما دون البشر”، كي يسهل على النازيين إبادتهم. السلطة في هذا الحالة هي بمثابة تفوق عنصري لأهلها يبيح إبادة من هم خارجها، والحاجز هو السلطة وقد استُثيرت وخرجت من مقارها المعتادة لتمارس طبيعتها في الاستباحة، قتلاً أو تعذيباً أو سطواً، أو كل ذلك معاً.
يقطّع الحاجز معيشة الذين هم خارج تنظيم “الدولة” التي يمثّلها، وهذا التقطيع الذي يبدأ النظر إليه “من جهة المستَهدفين” مؤقتاً، ولوظيفة مخابراتية، سيأخذ صفة الدوام ليصبح التقسيم أمراً واقعاً مع الوقت. الحي الآخر المجاور يصبح، بحكم الحواجز من الجهتين، ما يشبه بلداً آخر لا يتطلب السفر إليه مشقة عبور الحواجز فحسب، بل المخاطرة والتعرض للموت. هذا يحدث يومياً للذين يذهبون إلى أعمالهم، إن لم تكن في الحي الذي يقطنون فيه، ومن وظائفه الجانبية الاستنزاف المتعمد لأوقات هؤلاء في الذهاب والإياب بحيث لا يؤدون وظائف حيوية أخرى.
لقد حدث حقاً مع هذا التكتيك أن أصبح الحي الآخر مستقلاً، وبمثابة المجهول الذي لا يندر أن يتحول إلى العدو الذي يأتي “أو قد يأتي” منه الموت. في معظم الأحيان، أو جميعها، تسببت الحواجز مع سياسة الحصار بانقسامات، بعضها مناطقي وبعضها إثني وبعضها طائفي، وإذا كانت الحواجز النفسية قائمة نسبياً بين مختلف المجموعات فهي ستتعزز مع الحواجز. من النتائج الكارثية للحواجز تقطيع البلد إلى “مربعات أمنية”، ما أدى فعلياً إلى تمزيق إمكانية الاجتماع الوطني حول الثورة، وكان له دور حاسم في تقطيعها إلى جزر منفصلة، أو حتى متناحرة.
انطلاقاً من أن الحواجز هي عنف السلطة الفالت ضد السكان، وضد اجتماعهم، وأن ترهيبهم بمختلف السبل هو الأصل في فكرة الحاجز، يكون أمجد يوسف هو السلطة حقاً، أو الدولة وفق مفهومه عنها. أمثاله لا يمارسون الفظاعات وفق المتخيَّل الشائع عنها لدى الضحايا ومن في صفهم، إنهم يمارسونها كعمل تقني، كشأن من “بيروقراطية العنف” الخاص بدولتهم، العنف التقني الموجه لمن هم دون الدولة. ليس لدى أمجد وأمثاله إحساس بالذنب، ومن المرجح أن لديهم شعوراً بالرضا لأداء وظيفتهم، لذا لا يمنعهم عنفهم الوظيفي من أن يكونوا رقيقين مع أطفالهم أو حبيباتهم، وقد لا يمنعهم من كتابة شعر عاطفي عذب!
فضلاً عن واجب إنصاف الضحايا، بالسعي إلى محاكمة المجرمين من أمثال أمجد وصولاً إلى الجلاد الأول أو الأكبر، ثمة جهد “لا يتطلب موافقة دولية” يستحسن بذله لفهم الآثار المباشرة والمديدة للحواجز، ومن شأن مجزرة التضامن الإضاءة بقوة عليها. ذلك ضروري أيضاً لفهم جوانب عديدة من التمزق السوري، من أجل مئات الألوف، أو ربما ملايين السوريين الذين قُتل منهم شيء ما على حاجز.
المدن
—————————-
يمهل ولا يهمل: مجزرة حي التضامن مثالاً/ عبد الباسط سيدا
يُحكى أن صديقين، كان قد فرّقهما خلافٌ عميق، التقيا يوماً في برّية خالية والأمطار الربيعية تهطل بغزارة، فتتشكّل الفقّاعات من قطراتها الكبيرة المنهمرة بقوة. أحدهما كان يحمل سلاحاً، والآخر كان أعزل. ويبدو أن المسلح كان قد اتخذ قراره بقتل صديقه السابق وغريمه الراهن، بل صارحه بنيّته، فحاول الأعزل منعه من ذلك، محذّراً إياه أن جريمته سيُكتشف أمرها مهما طال الزمن. فأجابه صاحب السلاح بكل غطرسة: ومن الذي سيشهد على ذلك، فلا أحد سوانا في هذه البرية؟ فردّ عليه الأعزل: هذه الفقّاعات المائية ستشهد عليك.
وكان القتل. ودارت الأيام والسنوات، وشاءت الأقدار أن يكون القاتل جالساً مع زوجته في البيت، يراقب المطر الربيعي الغزير من النافذة، ويشاهد الفقّاعات المائية التي كانت تتشكل على الأرض، فابتسم، وكأنه يسخر من كلام المغدور. انتبهت الزوجة إلى ذلك، وأصرّت، بمختلف الحيل، على معرفة سر الابتسامة الغريبة، فأخبرها، بعد أن أكّدت له أن سره سيبقى في بئر مهجورة، بما حدث. ومرّت الأعوام، وتعكّرت الأجواء بين القاتل وزوجته. وفي يوم، اعتدى عليها بالضرب، وهدّدها بالقتل، فذُعرت لذلك، سيما أنه قد سبق له أن قتل صاحبه بعد الخلاف، فخرجت إلى الشارع لتصرُخ بأعلى صوتها، وتعلن أن القاتل المجهول الذي ارتكب جريمة البرّية قبل سنوات هو زوجها.
مناسبة هذه الحكاية، التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أخيرا، ويمثل حصيلة جهود باحثيْن يعملان في مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” التابع لجامعة أمستردام؛ أصرّا على معرفة سرّ الجناة، وهو تقرير صادم بكل المقاييس، يوثّق بصورة مهنية المجزرة التي ارتكبتها أجهزة سلطة بشار الأسد في حي التضامن الدمشقي عام 2013، عبر عناصرها، من بينهم المعروف باسمه أمجد يوسف، وهي مجزرة من بين مئات ارتكبتها السلطة المعنية، وتلخص بكثافة المأساة السورية المؤلمة المفتوحة المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً، وما زالت تنتظر الحل العادل، الذي يبدو راهناً أنه لا يعدّ أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، لانشغاله حالياً بتطوّرات الحرب التي أعلنها الرئيس الروسي بوتين على أوكرانيا، وتفاعلاتها الدراماتيكية التي تُنذر بجميع الاحتمالات. بل لا يعدّ الوضع السوري اليوم ضمن أولويات دول شقيقة وصديقة عديدة وقفت إلى جانب الشعب السوري في بدايات الثورة، ثم تغيرت أولوياتها بعد أن تلمست وقائع التفاهم الأميركي الروسي في الموضوع السوري، خصوصا بعد ضربة السلاح الكيميائي التي أقدمت عليها سلطة بشار في منطقة الغوطة صيف 2013؛ وساد اعتقاد في ذلك الحين أنها ستؤدي إلى تدخل دولي بقيادةٍ أميركيةٍ للمحاسبة بناء على وعود الرئيس الأميركي أوباما.
ولكن يبدو أن أمراً ما قد حدَث، وعلى الأغلب أن إسرائيل تدخلت، وكان التوافق الروسي الأميركي عن ضرورة تسليم السلطة المعنية مخزونها من السلاح الكيميائي، الأمر الذي فتح الباب أمام مزيد من التفاهمات والتوافقات بشأن مناطق النفوذ تحت شعار محاربة الإرهاب، والتخلي عن فكرة محاسبة السلطة. وهكذا حتى وصلنا إلى مسار أستانا، ولقاء سوتشي، واللجنة الدستورية، وبقية الخطوات التي لم، ولن، تساهم في تقديم أي حل للسوريين، في غياب إرادة دولية جادّة ترمي إلى وضع حد للمأساة السورية الناجمة عن إصرار سلطة مجرمة فاسدة مفسدة على التحكّم بمصائر السوريين ومقدّرات بلدهم وبأي ثمن.
مجزرة حي التضامن دليل جديد يؤكد أن “الأسد أو نحرق البلد” ليس مجرّد شعار، وإنما هو المحور الذي تتمفصل حوله سياسة سلطة بشار الأسد. والصور الصادمة التي وثقها التقرير المهني المشار إليه لا تعد الأولى في هذا المجال، فقبلها كانت صور مجزرة البيضا والغوطة والتريمسة ومعرزاف وصور القيصر وغيرها كثير كثير، ولكن جميع تلك الصور جاءت في غياب توجّه دوليٍّ فاعل نحو إدانة بشار الأسد وزبانيته، وإلزامهم بتحمّل نتائج جرائمه. لذلك، كانت الضبابية والغموض ملحوظيْن، حتى في تقارير اللجان الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان التي كانت تكلف بتوثيق المجازر، خصوصا مجازر الكيميائي، في حين أن مجلس الأمن كان، وما زال، مشلولاً بفعل الفيتو الروسي.
ملف حقوق الإنسان، على أهميته وأولويته بالنسبة إلى الشعوب، لا يؤثّر في تحديد سياسات الدول، خصوصا الكبرى منها، بكل أسف، إلا في الإطار الذي ينسجم مع توجّهاتها وحساباتها ومصالحها. ولدينا أمثلة سابقة كثيرة في هذا المجال، سواء في العراق أو ليبيا أو السودان وإيران ولبنان وفلسطين ودول أفريقية وأميركية لاتينية، وفي الصين وروسيا، فهذا الملف يُحرّك عادة لتسجيل النقاط، وتسويغ السياسات. وهذا هو ما يحظى في هذه الأيام بأهمية خاصة في الحالة الأوكرانية، إذ يجري تسليط الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا؛ فيما القوات نفسها ارتكبت جرائم أفظع في سورية، وقد مدّت روسيا السلطة هناك بكل أنواع الأسلحة، وساعدتها على ارتكاب الجرائم والمجازر بحق السوريين، وغطّت عليها سياسياً في مجلس الأمن. ومع ذلك، جرى تجاهل ذلك كله، بل كان التوافق الأميركي الروسي حول تقاسم المواقع، والتنسيق بين التحرّكات والعمليات، وأدّى ذلك كله إلى التشكيك في مصداقية المؤسسات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، هذا مع ضرورة تقدير الجهود الكبرى التي تبذلها تلك المنظمات في ميادين توثيق الانتهاكات من حيث الزمان والمكان والحجم، وتحديد هويات الفاعلين، إلا أن ذلك كله يُوضع على الرفّ، طالما أن الحسابات السياسية لا تسمح بإثارتها، أو بناء المواقف والقرارات عليها. ولكن ذلك كله لا ينبغي أن يكون باعثاً على اليأس، بل لا بد من الاستمرار في جهود التوثيق والبحث في كل الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة والمليشيات ضد السوريين على الأرض السورية، حتى الوصول إلى الأدلة القاطعة التي تدين المجرمين، رغم كل محاولات الإخفاء.
لقد أدّت جرائم السلطة، خصوصا المجازر المدروسة التي أقدمت عليها في المناطق المختلطة مذهبياً إلى تهجير أكثر من نصف السوريين، وقتل نحو مليون، وتغييب مئات الآلاف؛ هذا بالإضافة إلى تصاعد التوتر المذهبي البغيض في البلاد، وأتى ذلك كله، ويأتي، في سياق سياسة السلطة الخاصة بتفجير العلاقة الوطنية بين مختلف المكونات المجتمعية السورية، لا سيما بين السنّة والعلويين؛ وهي استمرارية للسياسة التي اعتمدتها هذه السلطة بالتنسيق مع حليفتها إيران في العراق بعد سقوط حكم صدّام حسين، إذ جرى تبادل الأدوار بغرض دفع العراق نحو الحرب الأهلية بين السنّة والشيعة، عبر تدبير العمليات الإرهابية الكبرى التي استهدفت المدنيين العزّل من الطرفين، ومن خلال تقديم الأسلحة والأموال والمساعدات اللوجستية للإرهابيين من الطرفين، وذلك لوضع العالم أمام بديلين سيئين: الاستبداد أو الإرهاب.
الوثائق التي نشرتها “الغارديان” بخصوص مجزرة حي التضامن في دمشق مؤلمة، وهي مبنيةٌ على جهد بحثي معرفي تقني شجاع صبور؛ والأمل اليوم معقود على مئات، إن لم نقل آلاف، السوريين المختصين بقضايا الانتهاكات الموزّعين في مختلف أنحاء العالم، فهؤلاء قد اكتسبوا، خلال الأعوام المنصرمة، خبراتٍ كثيرة، وأتقنوا اللغات، وبنوا العلاقات مع المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان في سائر أنحاء العالم، وكذلك أقاموا العلاقات مع المؤسسات الإعلامية الكبرى، وذلك كله يوفر أرضية مناسبة لمتابعة البحث التوثيقي في كل جرائم سلطة بشّار الأسد بحق السوريين.
ولكن ما لا بد أن ننتبه له، ونحذّر منه، هو الوقوع في أحابيل لعبة السلطة ذاتها من جهة تعميق الانقسام في المجتمع السوري على أسسٍ مذهبية أو قومية أو مناطقية؛ فهذه لعبةٌ قديمةٌ جديدةٌ تمارسها هذه السلطة منذ بداياتها قبل خمسين عاماً، فالخطاب المذهبي البغيض يولّد الأحقاد، ويقطع الطريق على المشروع الوطني السوري الذي يظل الملاذ إذا كّنا نريد وحدة الوطن والشعب. أما أن ننساق خلف الأهواء والنزعات والهيجانات التي تحرص السلطة على إثارتها واستغلالها، والاستفادة منها، فهذا فحواه أن نضع حواجز جديدةً بين السوريين، تمنع التواصل والتفاهم، وتقطع الطريق أمام أي إمكانيةٍ للتفاعل والعمل المشترك، وسيكون ذلك كله في مصلحة بشار الأسد وسلطته وراعيه الإيراني الذي اتخذ من موضوع إثارة الأحقاد المذهبية ركناً محورياً في سياسة زعزعة الاستقرار في جواره الإقليمي، وذلك ليتمكّن من التمدّد، والتغلغل، والتحكّم بمفاصل مجتمعات المنطقة ودولها.
—————————-
ذاكرة سوريا كبلد المجازر والمقابر الجماعية/ ساطع نور الدين
الكشف عن مجزرة حي التضامن في ريف دمشق، هو أشبه برحلة متأخرة تسع سنوات الى التاريخ، تستكمل مهمة الحفر في ذاكرة الحرب السورية، والتنقيب عن أشد مكوناتها توحشاً، وهو أقرب الى زيارة مؤجلة الى مقبرة ليس فيها قبور ولا شواهد ولا حتى أرقام..مثلها مثل عشرات المقابر الجماعية التي باتت تغطي مساحة سوريا.
المهمة جليلة بلا شك، ليس فقط لأنها تقاوم النسيان، بل لأنها تؤسس للمحاسبة والعدالة ولو بعد حين.. فضلا عن أنها تلفت الانتباه الى أن الحرب السورية لم تنته، ولم يتوقف القتل الجماعي، وبالتالي يمكن ان تسهم في ردع مرتكبي الجرائم الجماعية، ولو بشكل عابر، وجزئي، كما يمكن ان تعيد تسليط الضوء على تلك الحرب المهمشة.
شأن السوريين التدقيق في الوقائع والاسماء والتواريخ، وفي رسم خريطة مفصلة للمقابر الجماعية، وفي تحويل تلك النتائج الى محاكمات دولية، تحمي من تبقى منهم الداخل السوري، وتنصر المهجرين الذين لم يبق لهم سوى ذلك الرجاء..وتكون في المستقبل أحد أسس إعادة بناء سوريا الدولة والمجتمع.
لكن أصعب ما في الكشف عن مجزرة حي التضامن، انه لا يخترق جدار الصمت المحيط بالحرب السورية، وبالتالي لا يفتح ثغرة في مساعي إنهائها، على الاقل من زاوية ضم ملف تلك المجزرة الى ملفات المجازر التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا..أو ربما التكهن بأن الغرب يمكن أن يستخدم سوريا كجبهة مواجهة خلفية مع روسيا، عندما تبلغ الحرب الاوكرانية ذروتها الروسية.
التوجه الى الغرب مجدداً، لوضعه أمام مسؤولياته، لم ولن يجدي نفعا. لا سيما بعدما تغيرت الاولويات الغربية، التي لم تكن في الاصل مؤاتية للسوريين، لا في الموقف من النظام ، ولا حتى في مقاربتها القضائية الخجولة للفظائع الانسانية التي شهدتها سوريا طوال السنوات ال11 الماضية.
يبقى ان أغرب ما في الكشف عن مجزرة حي التضامن، أنه لم يحرج النظام ولم يحرك المعارضة، بإعتبار ان الامر من عاديات الحرب وطبائعها: ليس هناك جديد يستدعي مثلا أن يزعم النظام، كما جرت العادة، وجود تزوير أو تلفيق او تلاعب في الفيديو . وليس هناك جديد يتطلب من المعارضة ان تتعامل مع الأمر كملف وطني، قضائي وسياسي، لا يقتصر على بقعة جغرافية محدودة، خارج نطاق ولايتها “النظرية”، ويستدعي ربما مراجعة خيار التفاوض مع النظام.
التسليم الضمني السوري بأنه لم يكن هناك حدث إستثنائي، يفقد مساعي وقف الحرب أهم حوافزها، ويحيل الى الاستنتاج بأن النظام لم ولن يتوقف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وبأن المعارضة، بمؤسساتها الحالية، لم ولن تصبح مؤهلة لإنتاج عملية سياسية بديلة للمسار الحالي المعطل، ولم ولن تمتلك جرأة محاسبة القوى المناهضة للنظام، التي ارتكبت مجازر مشابهة لمجزرة حي التضامن..عدا عن التنظيمات الاسلامية التي تلطخت ايديها بالدماء قبل ان تصادر البيئة المعارضة وتحرمها من مقارعة النظام بالطريقة الانسب والاجدى.
وبانتظار ان يحين موعد تحويل الحفريات في ذاكرة الحرب السورية الى قاعدة او حجة لعمل سياسي تأسيسي، سيبقى الكشف عن أي مجزرة جديدة أو مقبرة جماعية اضافية، هو المخرج الوحيد المتاح من دوامة البحث عن السلام السوري المرتجى.
————————-
الجثة الأكبر في حفرة حي التضامن/ صبا مدور
دعتني مشاهد القتل في حي التضامن إلى التساؤل فيما لو كانت الحفرة التي هيأها أمجد يوسف وشركاؤه أكبر وأعمق، فكم كان سيكون عدد الضحايا؟ قتل هؤلاء 41 ضحية ثم أحرقوا جثثهم، ولكن كم قتلوا قبل ذلك وبعده حتى يومنا هذا؟ كان من الصعب تتبع تفاصيل المذبحة مع قسوة مشاهدها، لكن يظهر أنها ذات سياق، هناك ما قبلها وما بعدها. ليست عفوية أو رد فعل غاضب أو نزوة ناتجة عن عقل مريض فحسب. ومن خلال معاينة أدوات الجريمة، أمكن، على سبيل المثال، ملاحظة الإطارات المطاطية، التي هيأها القتلة داخل الحفرة لإحراق الجثث لاحقا، بينما تتحدث ملابس الضحايا عن هوياتهم، ويظهر أن بعض المغدورين اقتيد من بيته، وهناك من كان في الشارع مرتديا ملابس رسمية، أو في دكانه، أو يجر عربة خضار، وبالتالي ليس بينهم من هو مسلح. وحتى تكتمل عناصر التراجيديا، فإن حفلة القتل كانت أشبعت غرائز القاتل، الذي تفاخر بإزهاق الأرواح أمام الكاميرا، ولم يغفل توجيه تحية ل”المعلم”، والتسلي بإذلال الضحايا قبل دفعهم للحفرة، أو أمرهم بالمسير نحوها معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.
ما ظهر في المقطع المصور ليس كل شيء، هناك الكثير الذي لم تتحدث عنه الكاميرا، وكشف عنه تحقيق صحيفة الغارديان البريطانية، وفيه تفاصيل عن عمليات اغتصاب وقتل نساء وأطفال وابتزاز واسع النطاق وتعذيب واعتقالات وإخفاء قسري، وروايات من شهود واعترافات من القتلة، تنهي أي جدل بشأن مسؤولية النظام المباشرة عما حدث. ولا يبدو حي التضامن أول مسرح لجريمة من هذا النوع في سوريا ولا الأخير، فكل مدنها وبلداتها عرفت هذا النمط من القتل، سوريا كلها، باتت مسرح جريمة مفتوحا، أحالها بشار الأسد إلى مقبرة بالمعنى الحرفي، هناك على الأرجح مقابر جماعية لم يتم اكتشافها بعد، هذا عدا المجازر التي يعرفها العالم، ولم تحرك لديه رد، ومنها مجازر الغوطة وداريا، وخان شيخون وحلب وحماه.
أصبحت المجازر مجرد مذكرات رسمية وكتابات على مواقع الانترنت فيما يعيش القتلة يصولون ويجولون طلقاء، بل أن رئيس النظام الذي دشن هذا الطريق الجهنمي، يتصرف على نحو طبيعي حتى أنه يزور مركزا للأيتام، وعلى محياه شفقة كاذبة على أبناء ضحاياه، ما يجسد مشهدا مأساويا لحالة إفلات من العقاب هي الأسوأ التي يشهدها عالمنا المعاصر. أما ابتسامة الزهو على شفتيه، فهي ثمرة حركة تطبيع يتزايد معه، وتخلٍ عالمي عن شعب بقي تحت سطوته.
والسؤال الطويل والمتعب دوما، هو لماذا استمرت حفلات القتل في سوريا طوال 11 عاما؟ جزء من الاجابة، يمكن أن نراه وسط الجثث في حفرة حي التضامن، جثة هي الأكبر بينها، تكبر كلما ألقى أمجد يوسف ضحية جديدة في الحفرة، لقد كبرت حتى غطت على كل الضحايا، لكنها لم تكن تشبههم، ولا هي منهم، ذات الجثة التي تجول بين ضحايا المجازر في سوريا من حلب إلى درعا، ومن دير الزور إلى بانياس، تراقب حفلات القتل الجماعي، وحرق الجثث، ومشاهد البراميل المتفجرة، والقصف الكيمياوي، وفضائح التعذيب، وكل ما جعل سوريا قبرا وسجنا وملاذا للمجرمين والمرتزقة والميليشيات الطائفية الإيرانية من لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان، بالإضافة إلى “فرقة فاغنر” الروسية.
التجاهل السياسي جزء مما يجري، وإن لم يحمل بندقية ويقتل، ويشعل الحرائق. عدمُ رد الفعل أمام سورية ومأساتها، منحَ المجرم الفرصة تلو الفرصة للتمادي والاستمرار والإفلات من العقاب، ولم يتعامل المجتمع الدولي بالقدر المناسب أخلاقيا أو مهنيا مع الدراما السورية، كما يفعل الآن على الأقل مع الحرب الراهنة في أوكرانيا، فكان مجرد خصم غير مزعج للقتلة، فمنحهم فرصة التقاط الأنفاس، وسرد رواية مشوهة لما يجري وتزوير الحقيقة، بل وإعادة تأهيل ليعودوا بهيئة رجال دولة وحماة وطن.
أما الإعلام الذي من المفترض أن يكتب المسودة الأولى للتاريخ ويحيي قضايا الشعوب، فهو الجثة الأكبر وسط كل الحفر والقبور الجماعية في سوريا. هو الشاهد الصامت أو الأصم، أو أنه اهتم جزئيا وحسب ضرورات السياسة وضغوطها، وفي أحسن الأحوال وفق تقديرات مهنية.
ولا يمكن أن نعفي ضفة من الإعلام العربي، تتحكم به أجندات سياسية ومصالح، حتى أنه أضحى جزءا من مشهد التزييف والتضليل وغسيل الأدمغة لإعادة انتاج النظام في سوريا، لأغراض سياسية معروفة أهمها على الاطلاق خدمة إسرائيل، ودعم مصالحها الأمنية، لذلك جاءت مرحلة التطبيع مع نظام الاسد، في نفس سياق التطبيع مع إسرائيل.
ما الذي كان ينقص مجزرة حي التضامن، لتحظى بتغطية اعلامية مناسبة تعيد التذكير بأحد عشر عاما من القتل مع عشرات المجازر الكبرى الموثقة دوليا. وهناك سؤال يستحق التوقف أمامه، لماذا كشفت جريدة الغارديان البريطانية عن مذبحة حي التضامن، ولم تكشفها مؤسسة اعلامية عربية، هل علينا الانتظار في كل مرة تفضل الاعلام الغربي وكشفه عن قضايانا، رغم أن من بين المؤسسات العربية من يرى نفسه ندا للإعلام الدولي، وحقق بالفعل نجاحات جيدة في الصحافة الاستقصائية؟
كان يمكن تجاوز عقدة الغارديان، لو أفرد الاعلام العربي مساحات واسعة ذلك اليوم، تعطي المجزرة وما يرتبط بها ما تستحقه من سرد ونقاش وتحليل، في وقت مثالي يبدو فيه العالم مستعد من الناحية النظرية لإحياء ملفات جرائم الأنظمة الاستبدادية التي ترتبط بروسيا، لكن تحقيق الغارديان، الذي استغرق سنوات وباحثين وصحفيين، لم ينل على وسائل الاعلام العربية إلا خبرا وتقريرا يتيما كأي حدث عابر، ربما بسبب ما اعتبره البعض من الصحفيين أنها جريمة قديمة ومتكررة، وكأن الإجرام تخف حدته بالتقادم، أو قد يكون للانشغال بدوامة الأحداث الاوكرانية، وكلا السببين قصور في الرؤية والمهنية.
وحتى لا نقع في التعميم، يجب الاعتراف بأن هناك إعلاما عربيا مهما وواسع الانتشار، واكب المأساة السورية في أعوامها الأولى، لكنه وخارج السياسة وضغوطها ومتغيراتها، فشل في مواصلة المواكبة، وربما تعب منها، أو أنه أخضع ما هو أخلاقي وتاريخي وإنساني إلى اعتبارات نسب المشاهدة واتجاهات الاعلام الدولي والحسابات الشخصية للمشرفين على غرف التحرير، وميول الجمهور، حتى غرق في معايير وضعته في خانة الاعلام الذي يصرخ في وادٍ بعيد عن ساحة المسؤولية والشرف المهني، وبل وحتى عن أولويات القرب الجغرافي للحدث.
موقف الاعلام العربي من مذبحة حي التضامن غير مسؤول ومعيب أخلاقيا، فضلا عن أنه غير مهني، ولولا وسائل التواصل، وما أثاره الناس العاديون من إدانات وتذكير بجرائم النظام، لمضت هذه المذبحة بلا أثر، أو إحداث هزة لوجدان وضميرعربي ودولي، يأمل السوريون أن لا يكون قد تحول إلى جثة هو الآخر.
المدن
———————–
“هالوطن ما خدمني، دبحولي ابني”…عن حكايات ضحايا مجزرة التضامن/ كارمن كريم
“وسيم شعره ناعم يرده إلى الخلف وله وجه لطيف”، هكذا تصف الأم الحزينة ابنها… بتنا جميعاً نعرف وسيم الآن إذ نشرت العائلة صوراً له بالبدلة الرسمية وبابتسامة لطيفة.
“نحن لم نؤذِ أحداً حتى تتم أذيتنا والتمثيل فينا، توقعتُ كل شيء، أن يخرج هزيلاً أو أن يقتلعوا إحدى عينيه، لكن لم أتوقع أن يفعلوا هكذا به”، بحرقة بالغة تصف والدة وسيم صيام، وهو من ضحايا مجزرة التضامن، صدمتها حين شاهدت ابنها يُعدم، بعد اكتشافها هويته في الفيديو المسرب.
تعرفت عائلة وسيم صيام إليه خلال عملية إعدامه مع عشرات الضحايا في مجزرة التضامن، وهو فلسطيني سوري من سكان مخيم اليرموك، متزوج وله ابنتان وحياة عادية أسوة بجميع الذين سقطوا في ذاك اليوم، وهو ما يتناقض مع رواية النظام الذي يروّج فكرة أن ما فعله يندرج ضمن مشروعه لمحاربة الإرهاب.
خرج لنقل الطحين ولم يعد
وسيم خرج في ذلك اليوم للعمل ونقل الطحين إلى أحد مخابز حي الزاهرة، اتصلت به زوجته طالبة أن يجلب أسطوانة غاز لكنه لم يعد ولم تسمع العائلة عنه شيئاً من حينها… وسيم هو شهادة دامغة على كذب ادعاءات النظام، فمن قُتل لم يكن مسلحاً أو إرهابياً، بل مدني صودف مروره في الشارع، أو ينتمي لمنطقة دعمت الحراك أو شاركت في تظاهرات… إنها أسباب كافية للقتل من وجهة نظر النظام.
“وسيم شعره ناعم يرده إلى الخلف وله وجه لطيف”، هكذا تصف الأم الحزينة ابنها… بتنا جميعاً نعرف وسيم الآن إذ نشرت العائلة صوراً له بالبدلة الرسمية وبابتسامة لطيفة، مطالبة الجميع بتذكر وسيم من خلال هذه الصور وليس بصوره الأخيرة في المجزرة.
بدأ بعض الأهل يتحدثون الى الإعلام خارج سوريا، ومع كل حديث لأهالي ضحية جديدة ستكتمل الحكايات والصورة. نعم لقد خرجت قصة وسيم إلى العلن وبقيت 287 قصة مطمورة مع أصحابها في حي التضامن، إلا أن قصة وسيم بداية لظهور أسماء الضحايا وحكاياتهم، ما يشكل إدانة إضافية للنظام، بصفته نفّذ مجزرة بأبرياء لا دخل لهم بصراعه المفترض مع الإرهاب.
بحزن عميق تستغرب الأم كيف فعلوا ما فعلوه بابنها: “بشوف نملة بالطريق ما بيقدر يدعس عليها كيف عملوا هيك فيهن ما بعرف، قد ما كان الإنسان عدوه ما بيسخا يعمل فيه هيك”، ما تبرير النظام وعناصره أمام هذه الأم؟ هل هناك أي تبرير يمكن أن يجعل الجريمة منطقية؟ بالتأكيد لا، سبقت الأم النظام بالإجابة حين قالت: “حتى لو كان عدواً لا يمكن فعل ذلك به”.
النظام يدافع عن فلسطين بقصف الفلسطينيين
فيما ما زال نظام الأسد يؤكد دعمه القضية الفلسطينية، فإنه يعدم المدنيين الفلسطينيين في سوريا، فحي مخيم اليرموك مثلاً والذي يضم أكبر عددٍ من الفلسطينيين هو واحد من أكثر الأحياء التي تعرضت للقصف والحصار في مفارقة غريبة لجدية نظام الأسد في حماية الفلسطينيين! إذ تسبب بتشريدهم مرة ثانية وحرمانهم منازلهم، يقول والد وسيم المكلوم: “هذا الدمار والطيران الذي قصف الجوامع والأهالي وقذائف الهاون ليلاً نهاراً 15 ساعة، التدمير والطيران والهليكوبتر، أهذه هي القضية الفلسطينية!”، كان النظام يعتقل أبناء المخيم من مدخله ويضعهم في ميكروباصات، وكلما امتلأ ميكروباص ذهب بالمعتقلين ليأتي غيره، بعيداً عن أي معايير أخلاقية أو إنسانية. يقول والد وسيم: “أهل المخيم يعلمون أن أولادهم ذهبوا ولم يعودوا، كنا نقف في الصف كالغنم، ليهينونا على باب المخيم”.
يبدو أن النظام وإسرائيل تساويا في أفعالهما ضد الفلسطينيين، وبينما يحاصر الإسرائيلي غزة، فقد قامت قوات النظام السوري بمحاصرة مخيم اليرموك لأشهر ومنعت عنه الأغذية.
لطالما أوصى وسيم والدته ببناته في حال تعرّض لمكروه، بنات وسيم كبرن دون أن يعرفن شيئاً عن والدهن، كشف الحقيقة والمطالبة بالعدالة اليوم من مسؤولية الجميع، أمُّ وسيم تنتظر العدالة كما آلاف الأمهات، المرأة التي علّمت لـ38 سنة في المدارس السوريّة قالت: “قديش خادمة الوطن، هالوطن ما خدمني، دبحولي ابني”.
حتى اليوم لم يصدر النظام أي بيان حول المجزرة ولم يحاول حتى تبرير ما حصل، يعلم أنه خارج الحساب مسبقاً، وبعيداً من طريقة النظام في التعامل مع هذا النوع من القضايا لا يمكن اعتبار ما حصل في حي التضامن مجرد خطأ فرديّ، ولا يمكن فصله عن النظام السوري بأي حال، في الفيديو ليس أمجد يوسف ونجيب الحلبي وحدهما من يقومان بالجريمة، هناك أيضاً حوالى 11 من العناصر الآخرين لم يتم التعرف إليهم حتى الآن، أمجد ليس المجرم الوحيد لكنه نفذ المهمة، ولا شك في أن له شركاء ومحرضين ومصفّقين، بقيادة رأس النظام.
كثر من عناصر النظام هربوا إلى أوروبا بعد عامي 2013 و2014، اللذين شهدا ارتكاب مجازر فظيعة في حي التضامن وسواه، أي أن القتلة يعيشون اليوم في أوروبا كأن شيئاً لم يكن، وبذلك أصبح الجلاد والضحية لاجئين في بلاد الآخرين…
درج
————————-
السيرة العمومية لأمجد يوسف/ رستم محمود
غير البشاعة المتناهية، فإن المقطع المصور الذي بثته صحيفة “الغارديان” عن مجرزة حيّ التضامن السوري يكشف أبعاداً أخرى لنوعية العنف العاري الذي كان يمارسه المجرمون بحق الضحايا المدنيين العُزل، والتي غالباً ما تم فعل مثلها في باقي الفظائع. تلك الخصائص التي يمكن من خلالها القول إن تلك الفعلة هي الفضاء الكلي لمجتمع وسلطة وكيانٍ بكامله.
تلك التفاصيل والمعاني المتأتية من كون الجريمة لم تكون في سياق مواجهة عسكرية ما، بل بحق أناس مدنيين مستسلمين تماماً. ومن طبيعة الضغينة التي تلف سمات المقترفين، التي لم تكن طائفة فحسب، وإن كانت ذات سمات من ذلك.
لكن الأكثر جدارة بالملاحظة، هو كمية “الفرح” التي كانت تملأ وجوه الفاعلين، أحاديثهم الجانبية العادية أثناء تنفيذهم للجريمة، الهدوء ورتابة الفعل، استخدامهم لمستويات من التسلية واللعب مع الضحايا، وأولاً درجة الاستهتار بالجريمة، من حيث موقع الجريمة المكشوف واستسهال التصوير وعدم الاعتبار لأي تدبير أو خشية. فالفاعلون مثلاً ليست بينهم أي روابط عقائدية أو طائفية أو مكانية، خلا الانتماء إلى نفس المؤسسة الحاكمة، ومع ذلك، لم يكن أحدهم يخشى أن يكشف الآخرون “سرهم” هذا يوماً ما.
لأجل كل ذلك، فإن تلك الواقعة، ومثلها الآلاف التي لم يُكشف عنها حتى الآن، تدل بوضوح على “تراكم تاريخي” لهذه النوعية من الأفعال، أنتج هذا المستوى من “الرتابة” و”العادية” في ممارسة هذه الفظاعة.
كما تكشف بعداً هيكلياً لما تأتى منه المجرمون، باعتبارهم ممتهنين لمثل هذه الشيء ضمن تراتبية وضوابط داخلية فيما بينهم.
ذلك التراكم والهيكلة للعنف، شكلا سوية سيرة عمومية للبلاد السورية، بالذات من حيث علاقة أقوياء هذه البلاد بضعفائها، والسياق المؤسساتي المنظم، الذي صار بالضبط القانون العام في نفس البلاد. اللذان يشكلان معاً جوهر المسار السوري وسيرته العمومية، منذ التأسيس وحتى الراهن.
حدث ذلك، لأن السيرة العمومية لسوريا هذه، كانت قائمة على أربع أعمدة رئيسية في ذلك السياق.
فقد كانت سوريا هذه كياناً خالياً من أي سمة توافقية على الدوام مثلاً، سواء بين أمة الفلاحين والطبقات الإقطاعية/البرجوازية التي تحالفت مع سلطات عهد الانتداب الفرنسي في سنوات التأسيس، الإقطاعيون الذين ضخموا ملكياتهم بطريقة لا توصف، حتى صار الفلاحون أقرب لنماذج “العبيد” التقليديين.
وفي مراحل لاحقة، لم يكن ثمة أي نوع من التوافقية بين العسكر وعالم المدنيين، أو بين القوميين العرب الحاكمين ونظرائهم من أبناء الأقليات القومية الأخرى، أو بين أصحاب الهيمنة الرمزية السُنية على فضاء البلاد وباقي التشكيلات الطائفية السورية.
ضمن هذا السياق، فإن الجناة ليسوا فقط أبناء طائفة غالبة في مواجهة أبناء طائفة مغلوبة، أو أعضاء في طبقة حاكمة ضد أناس محكومين، بل هُم النتيجة الطبيعة لتراكم وهيكلة تاريخية لانتهاك أدنى عتبات التوازن وإمكانية الخشية المتبادلة بين الفاعلين والضحايا، هم الحلقة الأخيرة والنتيجة “الموضوعية” لوحشية سوء التوازن في الكيان السوري. الذي لا يشبه في وضعيته هذه أي من البلدان المحيطة، التي كانت على الدوام، وبالرغم من أنظمتها السلطوية، تملك في داخلها أشكالاً مستترة من توازنات ما، قادرة على منع حدوث إجرامٍ بكل هذا العُري.
إلى جانب ذلك، فإن ذلك النوع من الفجور هو المحصلة الحتمية لتراكم الإفلات من العِقاب، الذي يكاد أن يكون خاصية سورية محكمة، وأيضاً منذ التأسيس.
قادة الانقلابات الأولى في أواخر الأربعينيات، ومعهم جلاوزة سنوات الوحدة مع مصر، وما بينهما من حكام الانفصال وانقلابات البعث المتتالية، وحتى عصر العائلة الأسدية الطويل، لم يتعرضوا لأي محاكمة قط، مطلقاً.
فإما قُتلوا بطريقة ثأرية مثلما جرى مع الرئيسين، حسني الزعيم وسامي الحناوي، أو تعرضوا لاعتقال مديد دون محاكمة، كما في حالة الرئيس، نور الدين الأتاسي، وشريكه في الحكم، صلاح جديد، أو فروا من البلاد، مثل الرئيس، أمين الحافظ، والحاكم الفعلي لسوريا في عصر الوحدة، عبد الحميد السراج، أو انتحروا بـ”ثلاث رصاصات في الرأس”، كما جرى مع رئيس الوزراء، محمود الزعبي.
لم يقرأ أو يسمع أو يشاهد السوريون محاكمة، ولو صورية، لأي من قادة بلادهم. الذين كانت مصائرهم أشياء مبهمة وغريبة، لم تكن في أي وقت ضمن سياق تفوح منه رائحة المحاسبة والعقاب، بل كانت أقرب لنتائج الحروب الأهلية.
خلوّ القاموس العام السوري من أي تجربة للملاحقة والعِقاب، بالرغم من بحر الدماء التي تدفقت في الحياة العامة، حول مثل هذه الجرائم إلى “فعل عادي”، يمارسه القتلة وكأنهم في حفلة صيد، مليئين بالابتسامات والأحاديث الجانبية والتفنن بأجساد الضحايا.
إلى جانب الأمرين، فإن سوريا، وطوال قرنٍ كامل مضى، كانت مهد الكلام التقريعي، عن العروبة والتحرير والأمجاد والأمة والممانعة ومواجهة الإمبريالية والتصدي والصمود.
تلك الفخامة الخطابية التي كانت في الوقت الذي تتغزل فيه بالأماكن والوقائع والمخيلة، كانت تمحق بين حوافرها مصائر وحقوق ومعاني وحقيقة وجود بشر في هذا الكيان. بشرٌ من لحم ودمٍ وحياة ذات قيمة ومضمون.
الكلام السوري العمومي ذاك، نبتت في ظلاله أنواع متضخمة في القضايا والمؤسسات وأشكال المنطق والبداهات، التي كانت قائمة على نكران البشر العيانيين، ليس بمصالحهم وحقوقهم السياسية العليا فحسب، بل أيضاً بحقهم الأولي والمطلق بالوجود كبشر آدميين.
هذا التغييب المتراكم للبشر، حول أمة المواطنين السوريين إلى مجرد قطعان من الكائنات الرخيصة الحياة والمنذورة للتضحية بها في كل حدب، وأولاً على يد ملوك الكلام الفخم ذاك ومستخدميه.
أخيراً، فإن سوريا هي تلك البقعة المنسية من صخرة العالم، المتروكة لحروب الطوائف الكبرى والكيانات الإقليمية ولعبة الأمم.
هذا النسيان ليس وليد الحدث السوري الأخير فحسب، بل يكاد أن يكون سمة ملاصقة لطبيعة الدور السوري منذ عقود، سوريا التي كانت تؤخذ كبيدق في تلك الصراعات، بيدقٍ شديد الانغلاق والالتواء داخل نفسه، يتفاعل ويُتفاعل معه ككتلة صماء مع كامل تلك المعادلات، وعلى حساب أناسها غير المرئيين.
الحرة
————————–
جرائم البعث والخلافة/ إبراهيم الإدلبي
القتل والحرق نصيب المدنيين بين دولتي الخلافة والبعث
نشرت صحيفة الغارديان تحقيقا في السابع والعشرين من ابريل/ نيسان حول عملية قتل جماعية بحق ٤١ مدني معصوبي العينين، في حي التضامن الدمشقي السوري، على أيدي مجموعة من المخابرات العسكرية يرتدون زي الجيش السوري، ويدخنون السجائر وأصوات ضحكتهم أعلى من صوت الرصاص بعض الأحيان.
على غير العادة
خلال عملي كصحفي شهدت العديد من المجازر والانتهاكات التي حصلت جراء قصف جوي وبري ومقابر جماعية لمختلف القوى في سوريا.
لكن تسريب الغارديان كان له وقع خاص، فهول الصدمة ووقعها كان كبيرا.
العديد من التوثيقات التي نشرت لانتهاكات حقوق الإنسان غالبا ما يكون وجه الضحية واضحاً اما المعتدي يكون خلف الكاميرا او لا تظهر معالم وجهه، يقتصر الأمر على بعض الكلمات “مين ربك ولا” او “تكبيرات تصدح” لتكون آخر ما يسمعه الضحية في ظل غياب تام للعدالة.
اما تسريب الغارديان او ما اطلق عليه مجزرة حي التضامن كان الأمر مختلفا على غير العادة
وجوه تقتل بدم بارد، تبتكر اساليب جديدة في قتل الإنسانية قبل حرق ما تبقى من جثة الإنسان، لإخفاء أدلة الجريمة.
مقاربات بين الخلافة والبعث
في 2016 حصلت وكالة مسارات على فيديو مسرب لقيام عناصر من تنظيم داعش الإرهابي او ما يعرف بدولة الخلافة، يظهر في التسجيل عناصر من داعش يرمون جثث مدنيين في منطقة تدعى الهوتة بريف الرقة، والتي كانت ذات يوم منطقة سياحية، كما هي دمشق أرض الياسمين قبل ان تحولها الى دولة البعث إلى مقبرة تفوح منها رائحة الموت، الا ان داعش حولها لحفرة تبتلع جثث من يعارضها حيث يتم إعدامه في محاولة لطمس الحقيقة ودفن العدالة ونشر الخوف
يزحل عناصر التنظيم جثة ضحية مجهولة قتلوها ويستهزئون بوزن الجثة قائلين “ابن الحرام عايش على اللحم ما عاد يريد الحب” ثم يعطيه رقما فيقول ” الله اكبر المرتد الثاني” في إشارة إلى انه تم رمي جثة قبل هذه الجثة.
الأمر مشابه إذ نستذكر مجرم بعث اخر هو عصام زهر الدين والذي قام بدوره باسم البعث بحرق جثث المدنيين وتعليقهم على أعمدة الكهرباء ثم أخذ صور تذكارية معهم او قطع رؤوسهم وحملها بيده والتقاط صور تذكارية.
قطع رؤوس !!! نعم نعم في دولة الخلافة داعش كانوا كعصام ابن البعث يقطعون الرؤس ويتغنون حولها
بالعودة إلى مجزرة حي التضامن، وكيفية رمي المدنيين في حفرة تحتوي على إطارات بلاستيكية قبل إطلاق النار عليهم واضرام النار في اجسادهم، لقد كان القاتل في إحدى الاعدامات يطلق النار من الخلف على مدني القي في الحفرة قبل ان يسقط وكأنه يصطاد أهدافا طائرة للرماية بيد واحدة والآخرة في جيبه ويدخن السيجارة وكأنه في أعلى درجات الاندماج الروحي.
نعم إنها لذة القتل التي يتشارك فيها البعث والخلافة والضحية واحدة مدني اعزل ذنبه الوحيد انه يعيش في بيته.
مفارقات التعامل مع الخلافة والبعث.
لا ازال اذكر كيف أعدم تنظيم داعش الطيار الأردني حرقا، ولكن الذي لن انساه كيف تعامل المجتمع الدولي مع هذه الجريمة مقارنة مع جرائم البعث المستمرة، حيث تزاحمت بيانات دولية وتضامن مع أهالي الطيارة ودولته وصل إلى قيام القيامة فوق دولة الخلافة واجتمع الرئيس الأميركي مع ملك الاردن عقب هذا لتكثيف الضربات العسكرية لهذا التنظيم.
اما دولة البعث التي ما زال شياطينها الذين يرتدون اطقم ملونة يبثون السم في المحافل الدولية واكثر ما يحبط وجودهم في منظمة حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات التي وجدت لخدمة الإنسانية! بل وصل بهم حد القول ان دمشق أصبحت آمنة لعودة المدنيين، كما فعلت الدنمارك وغيرها، من محاولة إعادة اللاجئين الذين هربوا من الموت بهذه الطريقة او بابشع منها والتي بدورها لم تقنع المجتمع الدولي بعد ان دولة البعث لا تختلف عن دولة الخلافة داعش الا في ان الاولى مجرموها معروفين جميعا ويقتلون المدنيين امام عدسات الكاميرا للوصول الى مجتمع متجانس، اما الثانية يقتلون بوجوه مستترة باسم هو براء منهم.
اعيد شريط الفيديو مرات ومرات يوميا! أمجد يوسف ورفاقه! أسماء لن ينساها التاريخ دخلته من أوسع أبواب الإجرام وما هم الا بعثيون صغار يقتلون باسم البعث، ويجول في رآسي كلام قائد البعث دكتورهم الأسد كما يفضل بعثيوه مناداته، “المجتمع المتجانس” “سوريا لمن يدافع عنها”
إنه التجانس الذي يسعى إليه بعث الأسد من خلال قتل وتصفية كل مدني لم يؤمن به، كما دولة الخلافة قطعة نقدية معدنية تحمل وجهان.
——————————-
لم يتعبنا الموت… لقد أتعبنا الخذلان/ بسام يوسف
لا يهدأ وجع السوريين، ولا يهدأ أنين أرواحهم المتعبة، وكلّما أغمضوا أعينهم عن فاجعة، فاجأتهم فاجعة أشد، هكذا تمضي سنوات هذه المأساة التي لم تتوقف منذ عقود.
ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية خبره السوريون، فقد شاهدوه مراراً بأم أعينهم، وتحسسوه على أجسادهم، وفوق أشلاء أحبتهم، ومع كل هذا فقد صدمهم تقرير “الغارديان”، وأيقظ كل مواجعهم السابقة، وذكرياتهم التي يحاولون تناسيها عبثاً.
ما يصدم في مجزرة “حي التضامن”، ليس إعدام عناصر من أجهزة الأمن السورية لمواطنين سوريين مدنيين فقط، فقد أصبح الموت على يد هذه الأجهزة حدثاً يتكرر يومياً في حياة السوريين، وليس فقط طريقة إعدامهم التي تزلزل الروح، وليس إعدام مواطنين يظهر من ملابسهم أنهم معتقلون للتو، وربما قبل دقائق على حاجز ما، وبالتالي فإن إعدامهم ليس له أي سبب، حتى بنظر من اعتقلهم، ما يصدم أكثر من كل هذا هو هذا الاستسهال البالغ في قتل الآخرين، كأنّما القتلة أدمنوا إجرامهم، وكأنما يمارسونه بكل تلقائية وعادية، وكأنما ألفوا منظر الدم، والأجساد التي تتلوى من الألم، وكأنّما من يقتلونهم ليسوا بشراً من لحم ودم.
من نافلة القول إن فعلاً كهذا، وجريمة بكل هذه البشاعة، لم تكن لتتم لولا وجود ضوء أخضر صريح من جهات عليا، لا بل أستطيع القول، والجزم، أن هوية المستهدفين أيضاً محدّدة
من أين يأتي كل هذا الاستسهال في القتل، وكل هذا الحقد، وكل هذه المقدرة على الإجرام؟ وهل يكفي ما يتم تكراره عند كل جريمة أو مجزرة، أم إن هناك ما يجب البحث عنه، لفهمه وتفسيره، وربما هناك ما يجب الاعتراف به صراحة، وبلا مواربة، فلم يعد التعامي عنه مجدياً، أو مفيداً كما كنا نعتقد سابقاً، ولم تعد التورية المخادعة تفيد في بقاء هذه القشرة الهشة من تماسك اجتماعي زائف، فهذه المخادعة التي تلطينا خلفها لعقود، وأغمضنا أعيننا بسببها عن خطة ممنهجة، لزرع حقد أسود راح ينمو ويتغذى ويتمدد، وعندما آن وقت استثماره، أفلتوه وها هو يلتهمنا جميعاً.
من نافلة القول إن فعلاً كهذا، وجريمة بكل هذه البشاعة، لم تكن لتتم لولا وجود ضوء أخضر صريح من جهات عليا، لا بل أستطيع القول، والجزم، أن هوية المستهدفين أيضاً محدّدة، وبالتالي فإن ما قامت به المجموعة القاتلة التي ظهرت في أشرطة الفيديو، لم يكن قرارها، بل كان قرار جهات تقودها، ولن أخوض هنا في دوافع هذه القيادات، فقد أصبح معروفاً للسوريين.
ما استوقفني كثيراً، ليس في جريمة حي التضامن فقط، بل في مواقف ومجازر كثيرة غيرها، ومنذ انفجار الثورة السورية، هو الاندفاع الغريزي والأعمى والحاقد عند قسم من السوريين لقتل من ثاروا على النظام، حتى من دون أن يطلب منهم ذلك، بعبارة أخرى لقد كان صادماً بالنسبة لي أن يتطوع أفراد من السوريين المدنيين، بكامل رغبتهم واختيارهم، لممارسة القتل الهمجي، وهم بكامل حماستهم، وكأنما يخوضون معركة مقدسة.
ربما يذهب بعضهم لتفسير هذا الأمر، بغياب مفهوم الدولة بمعناه الحقيقي، وتغوّل المؤسسات الأمنية على الدولة والمجتمع، وانتفاء معنى المواطنة والقانون، ويضيف بعضهم فكرة اقتناع هؤلاء المتطوعين بما يقومون به كنتيجة لما سوّق له النظام عن مؤامرة تستهدف الوطن، وبالتالي فإنّ ما يقومون به هو في نظرهم فعل “وطني”، لا بل ذهب بعض تابعي النظام إلى طرح فكرة تقديس الجيش ومن يسانده، لإبعادهم عن دائرة الاتهام، ووصفهم بالمدافعين عن الوطن، رغم أنهم دمروه، وقتلوا مئات الآلاف من أبنائه، وشردوا الملايين.
لن أخوض في كل التفسيرات التي قيلت، رغم أنها تتعمد إخفاء الحقيقة، لكن لماذا نتجاهل عاملاً آخر، عاملاً أشد حضوراً، وأشد تأثيراً، ويكاد بنظري أن يكون الأساسي، وما عداه ليس إلا تغطية له، ومحاولة لتمويهه، وأعني بوضوح: “العامل الطائفي”.
للأسف، إن من يقارب هذا الموضوع، سيجد نفسه كما لو أنه في حقل ألغام، فالنصّ الذي سيُكتب سيُقرأ على الأغلب بدلالة رغبات القارئ وعصبيته، وليس بدلالة النص ومعناه، وهذا ما دفع كثيراً من السوريين للابتعاد عن الخوض في مقاربة كهذه، لكن إلى متى يمكن لنا كسوريين أن نتجاهل هذا الأمر، وأن نتهرب من مواجهته؟
أمجد يوسف، المجرم الأهم في جريمة “حي التضامن”، ليس مجرد عنصر أمن يقوم بوظيفة موكلة إليه، وليس مجرد منتقم لمقتل أخيه كما ادّعى، إنه باختصار شديد شخص – ومثله الكثيرون- يتصرف بدوافع أعمق من ذلك، شخص مسكون بعصبية وبثقافة حاقدة، لا تبرر لنفسه جريمته وحسب، بل وتمنحه الرضى عما يفعله، شخص يمكنه أن ينام مطمئناً، وبلا أي إحساس بالذنب حتى لو قتل المئات، وحتى لوكان من بين ضحاياه أطفال، ونساء، ورجال عزّل لا ذنب لهم.
هذه الثقافة الحاقدة المتوارثة، والتي نمّاها النظام عبر عقود وغذّاها، وحماها، هي التي دفعت أمجد وكثيرين غيره لأن يفعلوا ما فعلوه، وإن المواربة في فضح هذه الثقافة، والاستمرار في تجاهلها يعني بقاءَها، ويعني أن سوريا ستظل ماضية في مسار الدمار إلى ما لانهاية.
ليست هذه الثقافة المتخمة بالكراهية والحقد، والتي ترى في الآخر عدواً أزلياً، حكراً على جهة ما، إنها منتشرة في بنى المجتمع السوري كلّه، وإن يكن بدرجات متفاوتة إلى حد كبير، وتفاوت حضورها إنما يتحدد بفائض القوة المتاح، وبصيغة العلاقة التي تربط حاملها بالعائلة الحاكمة، وما تختزنه هذه العلاقة من قدرة على الإفلات من المعاقبة والحساب، واستباحة الآخرين.
القدرة على استباحة الآخرين، وحقوقهم، وضمان عدم المساءلة والحساب تتحدد بدلالة وحيدة هي دلالة الولاء للعائلة، ومدى الخدمة التي تقدمها ميزة حماية الخارج عن القانون لهذه العائلة، سواء في زيادة ثروتها، أو في ترويع السوريين وإخضاعهم.
تحضر المعادلة الطائفية بوضوح في هذه الصيغة من العلاقة بين السوريين، صيغة رسّخها حافظ الأسد كأداة شديدة الفعالية في تفتيت المجتمع السوري، وفي إخضاع الشعب السوري، واستعملها بشار الأسد وحلفاؤه الإيرانيون بوضوح في سنوات الثورة السورية.
آن أن نطلق كسوريين صرختنا الواضحة والصريحة في وجه القتلة الذين نعرفهم جميعا، وأن نفضح ثقافة القتل، بلا مواربة أو تعمية بحجة المقدس، فلا قداسة لثقافة قاتلة
إن فضح هذه الصيغة، وتعريتها واتهامها بوضوح هو مسؤولية كل السوريين، وإن القول الذي يسوّقه النظام، ويكرره بعض المثقفين وأشباههم بأن من يقفون مع النظام، ويرتكبون جرائمه هم من كل بنى المجتمع السوري هو محاولة لطمس حقيقة حضور الدافع الطائفي عند القسم الأكبر من مجرمي النظام.
قد يكون دافع بعضهم لطمس هذه الحقيقة نبيلاً برأيهم، فهم يرون أن الوطن في لحظته الراهنة، لا يحتمل الذهاب إلى مقاربات تزيد من عمق الجراح المفتوحة في جسده، لكن ألا تكفي كل هذه السنوات، وكل هذا الدم لكي يدفعنا كي نفتح السؤال حتى آخره؟
السوريون الذين شاهدناهم وهم يسقطون في حفرة الموت في حي التضامن، وفي حفر أخرى، ومجازر أخرى ارتكبت بحق السوريين من قبل هذه الجهة أو من قبل خصومها، لا يكون خذلاننا لهم بنسيانهم فقط، إنه أساس في التعمية عن وجوه قاتليهم ودوافعهم العميقة، وفضح من يقف خلفهم.
آن أن نطلق كسوريين صرختنا الواضحة والصريحة في وجه القتلة الذين نعرفهم جميعا، وأن نفضح ثقافة القتل، بلا مواربة أو تعمية بحجة المقدس، فلا قداسة لثقافة قاتلة.
ما زالت فينا قدرة على الفعل والتحدي، ولم يتعبنا الموت رغم كل اتساعه وبشاعته، ما أتعب روحنا هو الخذلان، خذلان من هم شركاء وإخوة في الوطن.
———————
حكايات الهول السوري المسكوت عنه…/ ماجد كيالي
لم تبدأ الحكاية السورية، أو حكاية السوريين، مع شقائهم وعذاباتهم والأهوال التي عاشوها، مع تقرير صحيفة “الغارديان” عن مجزرة حي “التضامن” الكائن ضمن منطقة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين (قرب) دمشق، فذلك التقرير تحدث عن حادثة معيّنة، لكن أهميتها أنها كثّفت تاريخ سوريا السياسي، ولخّصت طريقة تعامل النظام السوري مع شعبه.
لا تمكن الإحاطة بتاريخ سوريا المحجوب، أو المسكوت عنه، من دون فهم آليات عمل النظام الذي حكم ذلك البلد منذ أكثر من نصف قرن، وحوله إلى مزرعة عائلية خاصة، والذي اختزل الدولة، أو همّشها، إلى سلطة، بأجهزتها الأمنية، المتمثلة بالوحدات العسكرية، وأجهزة المخابرات، المتعددة والمتشعبة، وكلها فوق القانون، فتلك هي مصدر الشرعية، والقوة، في حين أن الوزارات، ومجالس الشعب، مجرد ديكور، ولزوم الشكل، أو الصورة.
في كل ذلك، فقد بات تاريخ سوريا، هو تاريخ عائلة الأسد، فلا شيء قبل ذلك، أو من دونه، فتلك اسمها “سوريا الأسد”، ما يفسر أن يساريين وقومجيين ومقاومجيين لا يلحظون وجود السوريين كشعب، ولا ما يحصل لهم، فكل ما يريدونه هو الاستمرار في سماع ما يحبذون سماعه من نظام المقاومة والممانعة من خطابات ضد الإمبريالية والصهيونية، حتى لو ظل ذلك مجرد حبر على ورق، أو للاستهلاك والابتزاز والمزايدة، وحتى لو ظلت سوريا لا ترد على اعتداءات إسرائيل المستمرة منذ سنوات!
في الواقع فإن مجزرة حي “التضامن” مثلها مثل كثير من المجازر، لكن أهمية تسليط الضوء عليها أتت من القدرة على كشف صور مرتكبيها، واستنطاقهم، وهو كشف يضاهي صور “قيصر” (اسم حركي)، التي سربها عسكري سوري سابق، استطاع تصوير جثث المدنيين من ضحايا التعذيب والقتل على يد النظام، حتى انشقاقه (2013)، وبلغ عدد الصور المسربة 55 ألف صورة لـ 11 ألف ضحية (مطلع 2014). ففي حينه أثارت تلك الصور ضجة كبيرة، أيضاً، وأقرت المنظمات الدولية بصحتها، ما دعا الكونغرس الأميركي إلى إصدار قانون “قيصر” (2020) الذي حدد فيه عقوبات على النظام السوري وبعض الأشخاص فيه.
أيضاً، لا يمكن التعرف الى تاريخ سوريا، وقصة علاقة النظام بشعبه، والى الهول السوري الكبير، من دون التعرف الى تاريخ السجون والمعتقلات السورية، أي السجون الرسمية والسجون غير الرسمية (في أقبية أجهزة المخابرات)، التي تعد بالعشرات، وذلك في حكايات السوريين، وشهاداتهم عن السجن السوري، وخصائصه الفظيعة، ما تجلى في شهادات أو روايات من عاشوها، أو كتبوا عنها. ويأتي في ذلك على سبيل المثال: “القوقعة، يوميات متلصص” لمصطفى خليفة، و”ناج من المقصلة” لمحمد برو، و”الشراقة” لسعاد القطناني (التي أعدت أيضاً برنامج “يا حرية” الذي وثق في حلقاته التلفزيونية شهادات عشرات المعتقلين في السجون السورية في مبادرة هي الأولى من نوعها)، و”خمس دقائق وحسب! تسع سنوات في السجون السورية” لهبة الدباغ، و”أجنحة في الزنزانة” لمفيد نجم، و”ماذا وراء هذه الجدران” لراتب شعبو، و”الشرنقة” لحسيبة عبدالرحمن، و”عينك على السفينة” لميّ الحافظ، و”نيغاتيف” لروزا ياسين حسن، و”نفق الذل” لسميرة المسالمة، و”قهوة الجنرال” لغسان الجباعي، و”تقاطع نيران” لسمر يزبك، و”خيانات اللغة والصمت” لفرج بيرقدار، و”بالخلاص يا شباب، 16 عاماً في السجون السورية” لياسين الحاج صالح، و”كمن يشهد موته” لمحمد ديبو.
الملاحظة هنا أن معظم تلك الكتب أو الشهادات، كتبت عن السجون في مرحلة ما قبل الثورة السورية (فترة الثمانينات والتسعينات)، أي أنها لأفراد جرى حرمانهم من حريتهم، والتفنن في تعذيبهم، وإذلالهم، لمجرد رأي، وكجزء من نهج اعتمده النظام لتدجين مجتمع السوريين وتخويفه وإخضاعه. وهو ما لفت إليه برهان غليون، في تقديمه لشهادة محمد برو (ناج من الجحيم)، بقوله: “لا يشبه معتقل الغولاغ في الحقبة السوفياتية، ولا غوانتانامو الأميركي، ولا سجن أبو غريب في العراق، إذ كانت وظيفة تلك المعتقلات إخراج المعتقلين من عالم السياسية والمجتمع وكسر معنوياتهم وتركهم يهلكون فيها، أما معسكرات الاعتقال السورية، وأشهرها معتقل تدمر، فلا تدخل في أي من تلك التصنيفات، فهي أشبه بمعسكرات الاعتقال النازية، التي لم تصمم لحجز المعارضين وتحييدهم، ولكنها أقيمت لإبادة جماعات قومية أو دينية”.
ورغم أن غليون يعتبر أنه “لا ينبغي لهذا التشابه أن يغيّب… الفوارق الأساسية الأخرى التي تجعل من معسكر الاعتقال الأسدي نموذجاً فريداً من نوعه… فبينما تكاد الوظيفة الرئيسة لهذه الأخيرة (للمعتقلات النازية) تقتصر على التنظيم العقلاني بل الميكانيكي لهذه الإبادة الجسدية بعيداً من أي مشاعر أو عواطف أو اعتبارات أخرى، سوى القضاء على أكبر عدد من غير المتجانسين بأسهل وسيلة وفي أقصر ما يمكن من الوقت، يركز العمل في المعتقلات الأسدية على الإبادة النفسية أو الروحية لغير المتجانسين فرداً فرداً، بإطلاق كل ما تختزنه النفس الحيوانية لدى الجلادين من منابع الحقد واللؤم والنذالة والانتقام”.
ويفسر غليون ذلك بقوله: “ليس الموت هو ما يبحث عنه الجلاد هنا، وإنما استحالة الحياة، أو جعل الحياة مستحيلة من دون أن يكون الموت ممكناً، إنه العذاب… لا حاجة هنا الى غرف غاز تقضي على المدانين بالجملة، ولا الى محارق تخلي أماكنهم لوجبة أخرى. يتصرف الجلاد هنا وكأن الضحية عدوه الشخصي ويصر على أن يظهر في وجه خصمه كوحش مفترس لا تربطه أي صلة بالإنسانية… هكذا لا يتوقّف العذاب أبداً… لا يوجد جواب شافٍ على هذا السقوط في العدمية السياسية والأخلاقية”.
وكما قدمنا فإن تلك المجزرة هي جزء من صورة كبيرة، أو من مجاز كثيرة، شهدتها قرى سوريا وبلداتها ومدنها، ربما بدأت بداية في التريمسة والقبير والحولة حيث استخدمت ميليشيات النظام الأسلحة البيضاء (صيف 2012)، وامتدت إلى بانياس والرستن، ثم إلى دمشق وما حولها ودوما والزبداني والقابون وبرزة والمعضمية وداريا، وحمص وحلب ودرعا.
المهم أن كشف تلك المجزرة فتح ذاكرة السوريين مجدداً على كل تلك الآلام والفظائع التي عاشوها خلال السنوات الماضية، وربما أن هذا سيتكرر عند الكشف عن كل مجزرة أخرى، لا سيما مع بقاء مأساة السوريين على حالها، بغياب أي أفق لتغيير سياسي، يأتي بنوع من عدالة انتقالية مرتجاة.
النهار العربي
————————
بين حي التّضامن الدّمشقي وبوتشا الأوكرانيّة/ عبدالوهاب بدرخان
بين روسيا – بوتين وسوريا – الأسد مدرسة واحدة، بمنهاج وحشية موحّد، و”ثقافة” عنف تطوّر نفسها ذاتياً في فنون قتل الضمائر وإبادة الرحمة، ليصبح إعدام الأرواح ضرباً من الترفيه عن المقاتلين. أما التعذيب والتنكيل والاغتصاب والتلاعب بمصائر الأسرى، فليست سوى وسائل للتسلية وتمارين على الإنكار المطلق لإنسانية الضحية. لا يرتقي الجلّاد إلى وظيفته إلا بعد أن يصبح أي شيء باستثناء أن يكون إنساناً، فالحيوانات تجهل الإبادة والقتل للقتل، ولا تحرّكها سوى غرائز البقاء، تقتل لتأكل وتنجو … الإبادة بشرية، أجناس وطوائف تمحو أجناساً وطوائف. الإبادة جنكيزخانية، هتلرية، ستالينية، هوتوية، صربية، وأحدثها بوتينية وأسدية.
لا يمكن وصف المشاعر إزاء مشاهد القتل المبرمج في فيديو مجزرة حي التضامن في ضاحية دمشق. أشخاص التُقطوا على الحواجز، سيقوا معصوبي الأعين إلى حفرة الإعدام، ثم أُضرمت النار في جثثهم. الصور تؤكّد أنهم كانوا في الحيّ ولم يعودوا، وهناك من تعرّفوا إليهم وسمّوهم. جميعهم مدنيون، رجال ساعون إلى حاجات عائلاتهم، ونساء (في فيديوهات أخرى) قادهن سوء المصير إلى ذلك المكان. ولا يمكن أن يكون المجرم أمجد يوسف اقتادهم فقط لينتقم لقتل أخيه، بل إنه، كما قال، كان يمارس “عمله”، بإشراف رئيسه ياسر سليمان، ومشاركة رفاقه حسام عباس وصابر سليمان ونجيب الحلبي (الأخيران قُتلا لاحقاً). كانوا جميعاً ينفّذون “الأوامر”: القتل للقتل، والقتل للتهجير.
تلك كانت عينة من مئات المجازر في عموم سوريا، بعض منها في حي التضامن نفسه، إذ ظلّ الأهالي في حيّهم عام 2013 ولم يفهموا رسالة مجزرة داريا المجاورة (2012) حيث سُفك دم مئات غير محدّدة (أقلّها 440 شخصاً)، أو رسائل مجازر متزامنة نُفّذ بعض منها بمشاركة ميليشيات إيرانية كـ”حزب الله” وفصائل عراقية، أو لاحقة أكثرها شهرةً مجزرة القصف بالكيماوي (آب – أغسطس 2013). لم تبقَ زاوية في سوريا تتميّز بتعدّد سكاني، أو خصوصاً بتجانس طائفي معيّن، إلا واستهدفت بالقتل الجماعي، وكأن الخريطة الديموغرافية كانت تحت التمحيص منذ بدايات الحكم الأسدي وموضع تخطيط لإعادة هندستها. ويبرز حالياً حديث التغيير الديموغرافي من خلال اتهام الإيرانيين والأسديين للأتراك (في الشمال والشمال الشرقي) أو اتهامات المعارضة السورية لإيران التي تقيم مستوطنات على النمط الإسرائيلي. وتبقى أخطر الهندسات تلك التي نفّذها نظام الأسد بالمجازر، بقواته أولاً ثم بالتكافل مع حليفه الإيراني، ثم استكملها مع وصيّه الروسي.
أصبحت هناك توأمة فظائع بين الفرع الأمني 227 السوري ولواء المشاة المجوقل 64 الروسي، بين حي التضامن الدمشقي وبلدة بوتشا الأوكرانية المجاورة للعاصمة كييف. عُرفت أسماء مجرمي الحرب الأسديين، ووثّق الأوكرانيون أسماء عشرة عسكريين روس كانت وحشيتهم استثنائية. دخلوا بيوتاً وقتلوا قاطنيها، اغتصبوا نساءً ثم قتلوهن، أطلقوا النار على مسنّين وتركوا جثثهم ممسكة بأكياس الخبز والطعام على قارعة الطريق، جمعوا مئات في مراكز اعتقال ثم أقدموا على تصفيتهم قبل أن ينسحبوا. ولكي يؤكّد الرئيس الروسي أن المجازر حصلت بموجب “أوامر”، فقد وقّع على مرسوم خاص يشيد فيه بـ”بطولة وبسالة وشجاعة” هذا اللواء الذي استعان بعناصر مؤازرة من قوات “فاغنر”. وعندما استحثّت كييف وعواصم غربية عديدة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في “جرائم الحرب”، بادر الكرملين إلى نفي حصولها واعتبرها ملفّقة، لكن لا يمكن تكذيب الجثث والمقابر الجماعية. أما الأسد، فلم يكترث بالاتهامات الموجّهة إليه وإلى رجالات نظامه، وتولّت موسكو حماية جرائمهم ضد أي إدانة دولية. هذه المرة بات النظام الروسي نفسه موضع اتهام وليس الأسد مَن سيساعده على الإفلات من المحاسبة.
في حال أوكرانيا يُلاحظ الاهتمام بتفعيل التحقيق في جرائم الحرب، وذهب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وصفها بـ”جرائم إبادة”، أي إلى مساواتها بجرائم النازية، ربما لأنه أراد التذكير والردّ على إدّعاء فلاديمير بوتين بأن “اجتثاث النازية” أحد أهداف غزوه لأوكرانيا، إذ إن ارتكابات الغزاة ضد المدنيين في بوتشا وماريوبول وخيرسون لم تتمايز عن النازيين، بل أكّدت أن الجنود شُحنوا بعقيدة عنصرية حاقدة. أما بالنسبة إلى سوريا، فلم تكن هناك أوهام حول سمعة النظام وقواته، ولم تكن تنقصه نوازع الوحشية، لكن “الحرس الثوري” الإيراني رفده بالمزيد، وإذ تجاوزت ضحاياه الـ350 ألفاً، فقد توقّفت المراجع الدولية عن العدّ، كما لو أنها تبقي الحصيلة في حدود “المعقول”، لأن اعترافها بعدد أكبر من دون أي استعداد للمحاسبة يعني العجز الدولي المطلق.
حين شاعت المقارنة عالمياً بين ماريوبول الأوكرانية وحلب السورية، خصوصاً في مناسبة تعيين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف قائداً للحملة الروسية في أوكرانيا، استناداً إلى سجله الأسود في سوريا، أغفلت المقارنات أن عشرات المدن دُمّرت في البلدين المنكوبين، وأن ملايين السكان هجّروا، ولا يبالي بوتين بمصيرهم لأنهم ليسوا مواطنيه لكنه لا يكتم هدفه، فهو لا يريدهم أن يعودوا إلى مواطنهم بل أشار في بعض تصريحاته إلى ارتياحه لكونهم يشكّلون عبئاً اقتصادياً وعنصر ضغط على البلدان المجاورة لأوكرانيا. وكان الأسد قد جاهر في خطب متلفزة بأن اقتلاع مواطنيه من بيوتهم وأحيائهم كان بهدف تحقيق “انسجام مجتمعي”، وبالتالي فهو أيضاً لا يريدهم أن يعودوا.
لا يُراد لأهوال الحرب في أوكرانيا أن تلف المجازر ضد المدنيين بالنسيان، لذا تسارع وضعها على سكّة التدقيق والتحقيق ليُصار إلى وصم إحدى “دول الفيتو” الخمس بتهمة الإجرام الممنهج. وبالنسبة إلى سوريا، كان الظن أن ويلات الحرب طغت على المجازر وتجاوزتها، لكن ثمة ضميراً خارج إطار الدول ومصالحها لا يزال ينشط، وقد اخترق لتوّه الصمت بإخراج مجزرة حي التضامن إلى العلن، وقبله كانت صور “قيصر” واعترافات “حفار القبور”. وعلى رغم أن هذا الملف المتضخّم يُقابل بالاستهتار من جانب الحلقة الضيّقة لنظام الأسد، إلا أنه منع وسيمنع رفع العقوبات عنه وإعادة تأهيله. ويبقى أن بوتين فاوض وهو يقتل ويدمّر، إلا أنه يعوّل على الإنجازات العسكرية وليس على حل تفاوضي، أما الأسد، فقتل ودمّر وتظاهر بالتفاوض ولا يزال يرفض حلاً تفاوضياً. ولا عزاء لسذاجة المبعوث الأممي غير بيدرسون الذي يعتبر أن اجتماعات اللجنة الدستورية تساعد في “بناء الثقة”، ولا بأس في أن يدرج المجرم أمجد يوسف في عداد مستشاريه لتكون أطروحاته أكثر واقعية.
————————-
“السورية.نت” تحاور أنصار شحود معدة تحقيق “مجزرة التضامن”
لم يكن انتشار اسم الباحثة السورية، أنصار شحود على وسائل الإعلام الغربية والعربية ومواقع التواصل الاجتماعي “حدثاً اعتيادياً”، خلال الأيام الماضية، وإنما جاء بعد عمل وصفه سوريون بأنه “بطولي”، على مدى عامين ماضيين.
وكشفت “شحود” في تحقيق لها نشرته صحيفة “الغارديان” عن حيثيات وتفاصيل مجزرة “مروعة” قام بها عناصر من قوات الأسد في حي التضامن بدمشق في عام 2013، وراح ضحيتها أكثر من 250 مدنياً.
وتحمل الباحثة درجة الماجستير في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية من جامعة أمستردام و”معهد NIOD” (المعهد الهولندي لدراسات الحرب والهولوكوست والإبادة الجماعية).
وتعاونت في تحقيقها مع البروفسور التركي أوغور أوميت أوغور، أولاً في أثناء حصولهما على التسجيل المصور الذي وثّق الجريمة بتفاصيل دقيقة، وفيما بعد بالتواصل مع الجاني “أمجد يوسف”، بعد انتحال صفة شابة مؤيدة للنظام السوري، عبر “فيس بوك”.
وأظهر التسجيل المصور عناصر من مخابرات نظام الأسد، وهم يعدمون عدداً من المدنيين وهم معصوبي الأعين، وأيديهم مقيدة، قبل دفعهم إلى حفرة وإطلاق الرصاص عليهم ومن ثم حرقهم، في حي التضامن بدمشق.
كما كشف التحقيق عن هوية الجناة، على رأسهم “يوسف”، والذي كان يشغل بعد عام 2011 صف ضابط “مُحقِّق”، في فرع المنطقة أو الفرع 227، وهو فرع تابع للأمن العسكري “شعبة المخابرات العسكرية”.
وفي ما يلي حورا أجراه موقع “السورية. نت” مع الباحثة السورية، للوقوف على خفايا “مجزرة التضامن” وأهمية التحقيق، والخطوات اللاحقة لملاحقة المجرمين.
ما أهمية الفيديو؟
تحدثت شحود عن أهمية التحقيق، واعتبرت أنها تعود إلى مكان ارتكاب المجزرة، وهو حي التضامن الذي كان خاضعاً، حينها، لسيطرة نظام الأسد، وليس مناطق المعارضة.
وتقول شحود إن “المجزرة هي عملية تطهير كانت موجودة في حي التضامن، الذي كان خاضعاً لسيطرة النظام، وهذه أول مرة تجري بهذا الشكل”، مضيفةً أن ذلك دليل يثبت بأن “جرائم النظام ليست موجهة ضد مناطق المعارضة فقط، وإنما ضد كل شخص يخالفه”.
وأكدت شحود أن عملية التطهير جرت في الحي بين عام 2013 وحتى 2015، إذ كانت عمليات القتل تجري بشكل يومي في المنطقة، و”الحفرة التي ظهرت في الفيديو لم يتم ردمها في ذلك الوقت، واستخدمت أكثر من مرة لنفس طريقة القتل”.
وأشارت الباحثة السورية إلى أن الـ 41 ضحية الذين ظهروا في الفيديو هم جزء من آلاف الضحايا، وأن الفيديو هو دليل من أدلة أخرى جمعت في التحقيق، الذي توصل إلى 27 مقطعاً مصوراً. جميعها تحوي على مشاهد قتل في نفس المنطقة، ونفس المكان وأسلوب القتل.
وأكدت الباحثة أن ما يميز الفيديو هو “طريقة القتل المروعة التي قام بها أمجد ورفاقه في الفرع”، إذ أن “الطريقة فيها روتين قتل، عبر ارتكاب الجريمة دون توجيه أي كلام للضحية، التي لم تقاوم وسط صمت مرعب”.
كما يميز التسجيل بأن المجزرة وقعت في وضح النهار، وعدم وجود أصوات رصاص أو مواجهة أو مقاومة، “فالضحايا هم مدنيون عزل تم اعتقالهم من منازلهم أو الحواجز المحيطة”.
كما أكدت شحود أن التسجيل هو “جزء من جريمة أكبر والتي هي العبودية الجنسية، والاغتصابات التي تمت للنساء لسنين طويلة، إضافةً إلى الاستيلاء على الأملاك في المنطقة وتحويلها لسجون، إذ يوجد 50 سجناً في المنطقة إلى جانب عمليات التعذيب والقتل و”السخرة”.
هل هي مجزرة طائفية؟
ما جرى في حي التضامن وعملية التطهير يعود إلى عدة أسباب، حسب الباحثة السورية.
وأبرز هذه الأسباب يعود إلى “اختلافات سياسية واجتماعية وطائفية”، إضافةً إلى ظهور العمل المسلح من قبل “الجيش الحر”، كرد فعل على قمع النظام للمظاهرات واقتحام الحي، وهو ما أجج العنف من حال قمعية إلى حالة تطهير، ووضع جزء من أهالي الحي في مواجهة الجزء الآخر، حسب قولها.
وطالبت شحود بعدم التركيز والحديث عن وجود أبعاد طائفية في ارتكاب المجزرة في حي التضامن، خاصةً وأن مرتكب المجزرة وهو “أمجد يوسف” ينحدر من الطائفة العلوية، وإنما التركيز على “وجود نظام سياسي وأفرع مخابرات تقف وراء ذلك”.
وقالت شحود إن “التحقيق لم يذكر بأن المجزرة طائفية، بينما ذكر الطائفة التي ينحدر منها أمجد “يعود إلى ضرورة العمل البحثي، وتحليل شخصيته ونفسيته حول سبب القتل”.
وأضافت أنه لا يمكن أن “ننكر وجود شي طائفي بالجريمة لكن ليس هو الأساس. ممكن الطائفية جزء لكن ليس هي المسبب الأساسي للعنف.
كما “لا يمكن تفسير عملية القتل بحامل الطائفية كحامل وحيد، وإنما وجود قرار سياسي من قبل النظام، إذ أن أمجد ابن مؤسسة يأتمر بأوامرها، ودون موافقة النظام السياسي وأجهزة الأمن والحصول على ضوء أخضر، لم يكن له واغيره من المجموعات الموالية للنظام بكل طوائفها ارتكاب المجازر”.
وأكدت أن “الهدف العام للنظام إلغاء أي طرف آخر يمكن أن يشكل تهديد له، وعقاب جماعي لكل من يفكر الوقوف ضد النظام بغض النظر عن طائفته، فأي شخص يشكل خطراً على النظام هو عدو يحق له تصفيته”.
وأوضحت شحود أن التحقيق الذي نشرته الصحيفة والفيديو الذي انتشر شارك فيه سبعة أشخاص من الأقليات، ولم يكن لأحد منهم هدف طائفي وإنما العدالة.
وحول إمكانية تصفية أمجد يوسف من قبل نظام الأسد، اعتبرت شحود أن “النظام ليس غبياً لاغتيال أمجد وتهديد الأشخاص الذين يعملون معه بطريقة وفية”.
واعترضت شحود على نشر صور عائلة أمجد يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام أقاربه، معتبرة أن الشخص متهم فقط وليس العائلة وليست الطائفة.
كما اعترضت على نشر التسجيل الكامل، وظهور صور للأشخاص الذين تم تصفيتهم، معتبرةً أن ذلك يؤذي عائلاتهم، بقولها: “إن عائلات هؤلاء من حقهم أن يصلهم خبر مقتل ابنهم بطريقة فيها كرامة لهم واحترام إلى جانب اعتناء بنفسيتهم”.
ما الخطوات المقبلة؟
تحدثت شحود لـ “السورية. نت” عن الخطوات المقبلة بعد نشر الفيديو، وأكدت تسليم جميع الفيديوهات التي كانت بحوزتهم إلى الشرطة الدولية الهولندية والألمانية والفرنسية، والتي ستقوم بدورها التواصل مع منظمات حقوق الإنسان.
وأكد شحود أنها كباحثة ستستمر في البحث عن جناة الحرب في سورية.
واعتبرت أن “أهم ما يميز التحقيق هو الحفاظ على سردية الحرب في سورية، وتوثيقها بعيداً عن اتهامات شخصية، وعدم السماح للنظام باختراقها وإضعافها وطمسها كما حصل في مجازر حماة”.
—————————-
قبرٌ من دخان/ الياس خوري
بالأمس شعرت بأنني لم أعد أمتلك عيونا لترى.
رُميت في تلك الحفرة في حي التضامن، وصرت حفنة من رماد.
اقتادوني مغمض العينين، بيدين مكبلتين. مشيت كما أمروني، قالوا أسرع فركضت، لم أرَ شيئاً أمامي. فقدت صوتي، وامحت عيناي، ودخلت في اللهب الذي مزجني بدخان دواليب المطاط التي كانت في أسفل الحفرة.
لا أريد ضريحاً، فقبري من دخان.
لا أريد شيئاً، ولا أستجدي التعاطف من أحد.
أنا الأعمى وسط العميان، والقتيل وسط القتلى، أنا مجرد دخان أسود يتصاعد من حفرة.
هكذا كنت وهكذا سأكون، ولا أريد شيئا، ولا أبحث عن شيء.
***
هذا الكلام قاله الدخان، وأنا الآن أخون الدخان. أخون نفسي لأنني رأيت وقرأت. أخون الحياة لأنني لا أزال قادراً على التنفس. أخون الموتى بدلاً من أن أموت معهم.
اذا قلت لكم بأنني لم أستطع النوم، أكون كمن يضحك على حاله، اذا لم أنم بالأمس فسأنام اليوم أو غداً أو بعد غد.
أنا لا اسخر منكم بل أسخر من نفسي، واسخر من قدرتي على النسيان. سأنسى مذبحة التضامن مثلما نسيت صبرا وشاتيلا ومثلما نسيت دير ياسين والبياضة وتل الزعتر والدامور.
الذكريات تتراكم فوق الدم كي تمحو الدم قبل أن تمحو نفسها، وتصير مجرد لحظات عابرة نستعيدها كي نغطي النسيان بالإدعاء بأننا لم ننسَ.
الذكريات تتراكم فوق الدم كي تمحو الدم قبل أن تمحو نفسها، وتصير مجرد لحظات عابرة نستعيدها كي نغطي النسيان بالإدعاء بأننا لم ننسَ.
الهول السوري الذي نشر موقع “الجمهورية” تفاصيله، ونشرت “الغارديان” البريطانية مقاطع من فيديو مذبحة الدخان التي جرت في حي التضامن في دمشق، هو علامتنا في زمن النكبات.
لا مكان للكلام، كل وصف للمذبحة عاجز عن التعبير، كل الكلمات ابتذلت، كيف نصف قبورا من دخان؟
المذابح قتلت اللغة، والنسيان قتل الذاكرة.
كمن يصرخ في منام فلا يستمع إليه أحد، هكذا نصرخ اليوم، بلا أصوات أو حناجر.
سؤالي وأنا أقرأ وأشاهد كان موجهاً إلى نفسي. كيف أستطيع أن أعيش في هذه الحفرة التي يطلقون عليها إسم بلادي؟ كيف أستطيع أن أمشي في شوارع مكتظة بالموتى؟ كيف أجرؤ على الكلام في حضرة الصمت؟
لا أدري كيف استطعت أن أنظر في وجه القاتل، وكيف استطعت أن أحتمل مشهد يده التي تحمل البندقية التي أطلقت النار على الضحايا.
لكنني نظرت ورأيت. فضول الجريمة موازٍ للجريمة في وحشيته.
هل تحولنا إلى وحوش؟
وحوش أبرياء، يتفرجون على وحوش يهندسون الجريمة، هل هذا هو المصير الذي ارتضيناه لأنفسنا، ونحن نتلقى صفعات ذاكرة تستيقظ ثم تنام، ومهمتها الوحيدة هي أن تذكرنا بأننا لسنا أبرياء.
الناجون من مقبرة الدخان، أي نحن، ليسوا أبرياء لأن الشاهد يصير شريكا، حتى حين يحزن أو يتبرأ أو يشجب
الناجون من مقبرة الدخان، أي نحن، ليسوا أبرياء لأن الشاهد يصير شريكا، حتى حين يحزن أو يتبرأ أو يشجب.
ماذا نفعل بهذه العتمة التي استوطنت أرواحنا؟
كيف نستطيع البقاء؟
كلمة بقاء، اي مجرد الاستمرار أحياء صارت مفتاح أيامنا.
كيف نبقى ونحافظ على عقولنا وتوازننا الروحي وسط هذا الموج العالي من الشجن واليأس والشعور باللاجدوى؟
نبقى لأننا ننسى، لكن الجريمة لا تمحي لأنها هنا والآن.
نعيش مع الجريمة أي نتطبع بأخلاق لا أخلاق لها، ونبرر ما لا يمكن تبريره، ونستعيد حكمة ان الحي أفضل من الميت.
إنه الهراء.
نهترئ في الهراء، ولا خيار أمامنا.
نريد أن نبقى لأنه لا يحق لنا أن نموت، فالموت صار مبتذلاً إلى درجة مقززة.
إذ لم يكتف الطغاة واللصوص بابتذال الحياة بل ابتذلوا الموت أيضا.
ولكن كيف نبقى؟
هل نبقى جثثا تسعى في بلاد الخراب؟ أم نستعيد أصواتنا؟
لا تقولوا ان الصوت تلاشى في الصدى. فهذه الأصداء التي تطن في أرواحنا هي أصوات الضحايا.
تعالوا نستعيد صمت الضحايا كي نكتشف أصواتنا.
تعالوا نقرأ الإشارات الآتية من دخان الموت الذي يتسرب من المقابر الجماعية الموجودة في كل مكان.
روى الدخان أن الجريمة ليست فردية أو نتيجة نزوة أو بحثاً عن ثأر مثلما ادعى السفاح أمجد يوسف، كما أنها ليست مجرد متعة مَرَضية كما أشارت الى ذلك صورة نجيب الحلبي.
الجريمة نظام وبنية.
نعم نحن نعيش في نظام الجريمة، وهو نظام يشبه الفوضى لكنه منضبط على ايقاع امتهان الناس بشكل متواصل.
إنه بنية متكاملة، فهو ليس احتلالاً خارجياً يمتلك مشروعا واضح المعالم، ينفذ أهدافه بعقلانية مفرطة في وحشيتها، ويقتل لأهداف محددة.
لكنه احتلال من نوع آخر يمكن مقارنته بسلوك العصابات والمافيات التي لا هدف لها سوى النهب والقتل والانتقام.
نظام الجريمة تحكمه فكرة واحدة هي الانتقام من الناس عبر موت ذليل.
هذه هي خلاصة صور قيصر التي تستعاد اليوم مع صور مذبحة التضامن.
القتلة ليسوا أفراداً تحولوا إلى وحوش بشرية أو مرضى نفسيين، انهم جزء من آلة ضخمة، انها مطحنة للموت لا تتوقف عن الدوران.
ذكّرتنا مقبرة الدخان في حي التضامن بأننا نعيش في صفر الخراب، وعلينا أن نقاوم بأيدينا فإن لم نستطع فباصواتنا فإن لم نستطع فبموتنا
هذه الآلة التي وصلت إلى ذروة تجلياتها في المقتلة السورية المستمرة، تتحكم اليوم بالمشرق العربي برمته، من ساحل البحر الأبيض إلى شواطئ البحر الأحمر، محولة بلادنا إلى مقبرة كبرى للبشر والكلمات.
مقبرة بلا شواهد، ودخان يبتلع الكلام، وصمت.
لقد ذكّرتنا مقبرة الدخان في حي التضامن بأننا نعيش في صفر الخراب، وعلينا أن نقاوم بأيدينا فإن لم نستطع فباصواتنا فإن لم نستطع فبموتنا.
لقدس العربي
————————–
حول جريمة حي التضامن الدمشقي: إنها ليست جريمة حرب/ د. أحمد برقاوي
لقد روعتنا جرائم حزب الله وميليشيات الوسخ التاريخي الإيراني والداعشي وما شابه ذلك، فمن طبيعة الوعي المليشياوي وسلوكها المتطابق مع وعيها الإجرامي أصلاً.
ولكن الصعب على من يملك حساً عاطفياً أخلاقياً أن يستمر في النظر إلى الفيديو المتعلق بجريمة حي التضامن الدمشقي. بل إن الخيال الإنساني أعجز من أن يتصور سلطة حاكمة تقوم بمثل هذه الجريمة.
ولهذا فالجرائم الأسدية في سوريا ليست جرائم حرب، فهي ليست خرقًا لقوانين الحرب، لأن مرتكبيها لم يواجهوا جيشاً آخر، بل فاعلوها أبادوا مواطنين أحراراً ليس بينهم من يملك أدوات قتل، وليست جرائم ضد الإنسانية ترتكبها جماعات في أوطان غير أوطانها كالجرائم الصهيونية في فلسطين، بل جرائم جماعات همجية لا علاقة لها بالقيم الحضارية المتعلقة بالحق بكل أشكاله ترتكبها، أي هذه الجماعات، بحق أبناء وطن تنتمي إليه هذه الجماعات في الظاهر. وهي نمط من الجرائم غير مسبوق في تاريخ البشرية. فهذا القتل الجماعي للعزل بيد سلطة حاكمة للمحكومين واقعة تنتمي إلى لما بعد اللامعقول.
فجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي جرائم غير معقولة، لا معقولة، أما الجريمة الأسدية فهي جريمة تنتمي إلى ما بعد اللامعقول.
وهذه الجرائم غير المسبوقة في تاريخ البشرية جرائم كائنات تنتمي إلى عصبية سلطة تعصبية لا تنتمي إلى الإرادة الحرة لمواطنين أحرار. فعصبية السلطة اللامنتمية للوطن تنطلق من أن كل شيء مباح للحفاظ على بقاء السلطة. وهذا أحد معاني الجريمة الأسدية.
فعندما نقول عن هذه الجريمة، جريمة التضامن وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الحاكمة، جريمة أسدية فإننا نستخدم مصطلحاً يصلح ليكون عاماً.
عندها يكون لدينا ثلاثة أنواع عالمية من الجرائم يجب أن تتعامل معها الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية: جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، جريمة أسدية، وهي أبشع أنواع الجرائم.
ويجب أن يتضمن علم الجريمة فصلا بعنوان: الجريمة الأسدية ويعرفها ويشرحها ويدلل عليها بالوقائع، ليصار إلى تدريسها في كليات الحقوق وفي كل أنحاء العالم.
إن من لا يتعامل مع الجريمة الأسدية، من الأفراد والدول والمؤسسات المدنية بوصفها أخطر أنواع الجرائم، شريك أصيل بالجريمة الأسدية.
ومما يدعو إلى الاحتقار والقرف، قول بعض القوالين بأن هناك جرائم ارتكبتها داعش والنصرة وحزب الله وميليشيات الوسخ التاريخي الإيراني هي على شاكلة الجريمة الأسدية. أن تكون مليشيات داعش والنصرة وحزب الله وميليشيات الوسخ التاريخي الإيراني بإشراف المجرم قاسم سليماني، ميليشيات قاتلة ومجرمة فهذا مما لا شك فيه،ل كن هناك فرق بين جرائم ميليشيات، من طبيعة وعيها في ممارسة القتل، من جهة، وجرائم سلطة حاكمة ما زالت الأمم المتحدة ودول كثيرة تعترف بشرعيتها، جرائم بحق شعب من المفترض أن يهيب بالسلطة الحاكمة أن تحميه من سلب حق الحياة منه، من جهة ثانية.
ويمكن تعريف الجريمة الأسدية كالآتي:
الجريمة الأسدية هي جريمة سلطة همجية حاكمة تقوم بإبادة المحكومين الجماعية. وقد تقع هذه الجريمة في أمكنة أخرى من العالم ويكون اسمها جريمة أسدية، لأن الأسدية الحاكمة أول من استنت هذا النمط الفريد من الجرائم.
———————
عائلة أحد ضحايا مجزرة التضامن تروي لـ”العربي الجديد” شهادتها
————————

=================
تحديث 05 أيار 2022
———————
مجزرة حي التضامن… إننا نُحتضر!/ ماريا شهيل
لقد سمعنا تفاصيل مجازر مروّعة حدثت في الثمانينات من فم الناجين وسكتنا وسكت معنا العالم كله، وشهدنا مجازر أخرى خلال السنوات الأخيرة، ونعرف بالاسم مجرمي حرب ولصوصاً وقتلة ومهربين ونتعامل معهم على أنهم جزء من هذا المجتمع العريق.
نحن عملياً نحتضر… ولكن الموت يمهلنا لسبب أو لآخر…
أدركنا ذلك منذ سنين وأغمضنا أعيننا لنعيش، تاريخ هذا البلد متخم بالمجازر المرتبطة مباشرة بورطة استخدام عقولنا في التفكير. وهناك جمهور عريض من المثقفين يقدّم التحليلات السياسية المناسبة لكلّ مجزرة جديدة، ويذكّرنا بالمجازر التي حدثت في هذه المنطقة وفي كل الكرة الأرضية وعبر تاريخ البشرية… عند كل “مذبحة” جديدة تُفضح، يبررون الدم بتعديد مذابح الآخرين. وكأن الدم يبرر الدم، وموت الناس القسري قضية ثانوية، ولا حرمة للضحايا. فإذا كانوا من المعسكر المعادي لا بأس، فلنشمت بهم، إنهم يستحقون الموت!
وكانت مجزرة التضامن التي تعود إلى عام 2013، والتي كُشف سرها راهناً، آخر تلك الجرائم التي تخضع للتحليل والتبرير والمراوغة.
ماذا تطلبون منا الآن؟ اعتبار الإجرام مجرد جزء من سياق التطور الطبيعي للإنسان؟ ويحدث أن ما يفعلونه يذكرنا فعلياً بتاريخ المجازر الإنسانية التي ارتكبت على هذه الأرض.
لقد سمعنا تفاصيل مجازر مروّعة حدثت في الثمانينات من فم الناجين وسكتنا وسكت معنا العالم كله، وشهدنا مجازر أخرى خلال السنوات الأخيرة، ونعرف بالاسم مجرمي حرب ولصوصاً وقتلة ومهربين ونتعامل معهم على أنهم جزء من هذا المجتمع العريق.
نحن نتشارك جميعاً بلا استثناء في هذه الجرائم. تحمل الأطراف المتصارعة في المنطقة المنطق ذاته والأخلاق ذاتها وتتقاتل وسط غابة لا يحكمها قانون ولا يعترف فيها أحد بشريعة الآخر.
وسواء اطّلعنا على مجزرة جديدة موثقة على شريط فيديو أم لا فإن ذلك لن يكون سبباً لأي رد فعل اجتماعي أو سياسي أو حتى أخلاقي، لأننا ببساطة اعتدنا على التعايش مع الرعب والخنوع. اعتدنا أن نكون محكومين من سلطة تأسست على الحقد وبنت قواعدها على السرقة والقتل. سلطة غاشمة تنقلب حتى على أبنائها إذا اقتضى الأمر. لا تحتمل النقد وتقيّم المواطنين بحسب درجة تفاعلهم مع استبدادها فكلّنا “مفيشون” بدرجات تتراوح بين المؤيد المتحمس والمعارض وتنتهي بالمتمرّد الذي ينتهي في الدرك الأسفل من أقبية المخابرات السورية. وهذا الواقع على ما يبدو لن يغيّره شيء، فحتى الحرب التي استمرت نحو 11 سنة وأكلت الأخضر واليابس، الأحياء والأموات، لم تستطع استعادة حقوق السوريين ولم تستطع اقتلاع هذه السلطة وقوانينها وأخلاقياتها البائدة.
التغيير السياسي كما يتخيله بسذاجة السوريون لن يجدِ نفعاً. نحن بحاجة إلى إعصار يضرب أساس عقلياتنا التي تعفّنت وصارت تنكر ما تراه أمامها لتبرّر معتقدها وتنفي معتقد الآخرين. نتشارك التراب واللغة والملامح والأذواق ونتصارع على تفاصيل تاريخية أُشبعت بالغلّ وحُمّلت أكثر بكثير مما تحتمل.
أن نعيش في الماضي فهذه لعنتنا الكبرى.
الماضي ينتمي إلى التاريخ وآن لنا أن نعيش في الحاضر ونعترف بأن المجازر الإنسانية عار وأن من يتعاطف معها أو يبررها، إنما يطبّع مع الجريمة ويشجّع على المزيد.
درج
————————-
مجزرة التضامن تحفر في جروح الذاكرة/ ياسمين المشعان
بعد أحد عشر عاماً من تجارب مروعة لا يمكن وصفها، بما في ذلك فقدان خمسة من إخوتي بين القتل والإخفاء القسري، كان قد وصل بي الظن إلى أنه لم يعد هناك شيء يمكن أن يصدمني مرة أخرى، أو يمكن أن يفتح جروحي التي أخذت وقتاً طويلاً حتى بدأت تندمل. ولكن بينما أكتب اليوم، أدركتُ أن الجروح التي أحملها بعيدة كل البعد عن الشفاء، وأن إجرام نظام الأسد ما زال بإمكانه أن يَجرّني إلى أقسى اللحظات، اللحظات التي خسرت فيها إخوتي.
منذ سنة تقريباً، وفي محاولة مني للتأقلم مع الخسارات، بنيتُ جداراً بيني وبين ذكرياتي، لأبتعد بنفسي عن أي شيء قد يوقظ الصدمة في داخلي، حتى جاء التحقيق عن المذبحة التي راح ضحيتها واحد وأربعون شخصاً، على يد المخابرات السورية، في حي التضامن بدمشق عام 2013. بدأت قراءة النص بمجرد أن شاركه معي أحد الأصدقاء. أعادتني كل جملة وكل تفصيلة فيه إلى اللحظات المشابهة التي شهدتُها في الماضي. أتوقف قليلاً، أستنشق بعض الهواء، ثم أعود لمواصلة القراءة، إلى أن وصلت إلى جملة معينة هدمت الحائط وسمحت للذكريات بالتدفق: عندما قال المجرم أمجد بأنه يقتل انتقاماً لأخيه.
كيف يستطيع أحدٌ أن يقتل واحداً وأربعين شخصاً بحجة الانتقام لأخيه الذي قُتل سابقاً؟
لقد خسرت خمسة من إخوتي ولم أسعَ يوماً للانتقام، ولم أوجّه اللوم على مقتلهم سوى للنظام وأجهزته الأمنية. لم أستطع مشاهدة الفيديو الكامل الذي يظهر فيه تنفيذُ الإعدامات بدم بارد.
فكرتُ فوراً في كل العائلات التي ظهرت صور أبنائها في الفيديوهات المسربة. بالتأكيد كانوا يبحثون عنهم منذ اختفائهم. تواصلَ معي أحد الأصدقاء، وأكَّدَ لي أنه أعاد مشاهدة الفيديو أكثر من مرة باحثاً عن ابن خاله بين الضحايا، ولكن الوجوه لم تكن واضحة بالنسبة له.
الجريمة بشعة وقاسية، لكن الأبشع والأقسى أن تضطر للبحث بين صور الشهداء على قريب لك لتعرفَ مصيره.
عشتُ تفاصيل هذه القسوة كلها حين عثرتُ على صورة أخي عقبة بين صور قيصر المُسرَّبة، وذلك بعد انتظار دام ثلاث سنوات منذ اعتقاله. ذاك الانتظار الذي كلفنا ثلاثة آخرين من إخوتي، ربما لم أكن لأفجع بخسارتهم لو أني عرفتُ مصير عقبة منذ البداية.
كان يمكن أن نرحل عن البلد، ولكننا بقينا بانتظاره.
هذا الانتظار نفسه مرّت به، ولا تزال تعيشه اليوم، عائلات المعتقلين والمغيبين قسراً في سوريا. آلاف العائلات مثل عائلتي أُجبِرَت على هذه التجربة القاسية، أن يبحثوا عن أحبابهم بين صور قيصر. فكرتُ فيهم جميعاً أثناء قراءتي للتحقيق عن مجزرة التضامن.
تذكرتُ أخي بشار الذي خطفه تنظيم داعش في دير الزور منذ سنوات، و لم أعرف شيئاً عن مصيره حتى اليوم.
أعادني توثيق جريمة التضامن إلى لحظة توثيق استشهاد أخي زهير، عندما وصلنا مقطع مُصوَّر تظهر فيه لحظة إطلاق النار عليه، من جانب عناصر الأمن السوري، أثناء مشاركته في مظاهرة في دير الزور.
عندما رأيت صورة عقبة بين صور قيصر، قرّرتُ أنه لم يعد هناك شيء أخشى عليه، وبدأت نضالي نحو العدالة حتى يأتي يوم نستطيع فيه تشييع عقبة مثلما شيّعنا زهير.
بينما كنتُ أتابع القراءة، تذكرتُ لحظة اغتيال أخي عبيدة على يد قنّاص أثناء عمله في إسعاف الجرحى في دير الزور. تذكرت أخي تشرين، الذي قتل أيضاً برصاص قناص في منزله بعد عشرة أيام فقط من استشهاد عبيدة.
إجرام النظام ليس جديداً علينا، ولن يتوقف. لكن هذا التحقيق دفعنا إلى استرجاع ذاكرتنا، وجعلنا نعيش مجدداً الألم نفسه الذي خبرناه سابقاً.
الآن، يجب أن نتسلح بهذه الأدلة والبراهين لمحاكمة المسؤولين على جرائم الحرب، علّنا نستطيع يوماً محاسبة كل مجرم ومُنتهِك. كذلك، يُشكّلُ هذا التحقيق رسالة واضحة إلى الدول التي بدأت بالتطبيع مع النظام المجرم، رسالة تقول إن أيديهم أيضاً ملوثة بدماء السوريين والسوريات.
اليوم، لم نعد مجرد ضحايا ولا ناجين/ات فقط، بل نحن أيضاً قادةٌ في مسارات التغيير.
نحن أصحاب القضية، والنضالُ نضالنا، ويتوجب على المجتمع الدولي مشاركتنا في كل خطوة نحو العدالة: الخطوات التي نمشيها نحو الكشف عن مصير أحبتنا، وإطلاق سراح الأحياء منهم، ومحاسبة المنتهكين، وجبر الضرر عمّا وقع علينا من انتهاكات.
موقع الجمهورية
————————–
عيد حزين في حي التضامن/ إبراهيم العلوش
التقرير الاستقصائي الذي نشرته صحيفة “الجارديان” اللندنية، الأربعاء الماضي، حول مجزرة في حي التضامن الدمشقي، أعاد تسليط الأضواء على جرائم نظام الأسد، وأخرج عيّنة من جرائمه أمام الإعلام العالمي، وحرّك موقد ذكريات السوريين عن أحبتهم المختفين، واستعادوا ما وقع عليهم من جرائم نظام الأسد.
الصحفية السورية أنصار شحود وشريكها في التقرير الاستقصائي أور أوميت أونغر، عملا خلال ثلاث سنوات (2019- 2022) من أجل التحقق من صحة عدد من الفيديوهات عن مجزرة حي التضامن التي قادها في العام 2013 صف ضابط في الأمن العسكري الفرع “227”، أو ما يدعى فرع المنطقة، وكان صف الضابط أمجد يوسف قائد العمليات للفرع المذكور في حي التضامن.
يوثّق التقرير قتل 41 مدنيًا سوريًا تم اقتيادهم من الحواجز ورميهم في حفرة كان قد أنشأها الفرع المذكور في شارع جانبي بحي التضامن جنوب دمشق، بين حي الميدان ويلدا، والذي كان يحوي الكثير من أبناء الطوائف السورية، في نسيج غني من التنوع بكل ما يحتويه الطيف السوري.
يرمي المجرم أمجد يوسف مع مساعده نجيب الحلبي المعتقل المدني المعصوب العينين بعد إيهامه بالقفز لوجود قناص في الشارع، وعندما يقفز يرتمي في الحفرة، ويطلق العنصر الآخر عليه النار. وقد وثّقت الفيديوهات حتى عملية حفر المقبرة الجماعية، وحرق الجثث بالدواليب والمازوت وردم الحفرة التي تثبّت الصحفيان من وجودها عبر دلالات الكتابة على الجدران، وعبر مرشدين محليين تعاملا معهما بسرية.
استطاعت الصحفية شحود الإيقاع بالمجرم الرئيس عبر عقد صداقة معه في “فيسبوك” باسم وهمي، وتمكّنت من إجراء لقاءات مطولة معه، وتوثيق أقواله التي يفتخر فيها بالقتل وهو يقرّ علنًا أنه قتل الكثيرين. وبيّنت المقابلات حتى تفاصيل المكتب الذي كان يحتله في فرع الأمن العسكري المذكور، وأورد التقرير اسم رئيسه المباشر، ورئيس الفرع الذي كان يدير تلك العمليات، وأسماء المجرمين المساعدين من أصحاب السوابق، حتى إن التقرير سمّى مجرمًا معروفًا بعدد من جرائم الاغتصاب في حي التضامن، وقد تم إخراج أمثاله من السجن عبر إعفاءات الأسد الخاصة للمجرمين الذين من الممكن أن يستفيد منهم في الجرائم ضد المدنيين السوريين والتبرؤ من مسؤولية أجهزته عنها.
ما يلفت في التقرير هو التفاصيل الكثيرة الموثقة والملاحظات العميقة، مثل الحقد الذي يتم خلاله تنفيذ القتل، وصوت الضحك الذي كان أكثر إيلامًا من صوت الرصاص، كما قال أحد الصحفيين، والتحقير الذي يناله المدنيون الذين لا يدرون ما المصير الذي يساقون إليه وهم غير مسلحين ولا محترفين، بل وصلوا إلى المجزرة بثيابهم العادية كأنهم ذاهبون لشراء ربطة خبز أو طبق بيض من “البقالية” المجاورة لبيتهم، وكذلك الإهانات الشديدة للنساء واستعمال الألفاظ الجنسية المقذعة ضدهن بشكل مضاعف عن الرجال الذين نالهم الكثير من الشتم الحقود إلى درجة مذهلة.
يفتخر أمجد يوسف بعمله، ويوجه عبر الكاميرا تحية إلى رئيسه في العمل، وهو يصوّر عمليات القتل التي يقوم بها، وبدا محترفًا، خاصة أنه ورث مهنة الجلاد عن أبيه الذي كان أيضًا مساعدًا أول في المخابرات أيام الأسد الأب.
ملاحظات وأسئلة مهمة يثيرها التقرير، مثل لماذا يصوّر جلادو الأسد أنفسهم في أثناء ارتكاب هذه الجرائم ويعصبون أعين ضحاياهم، بينما جرائم “داعش” تتم بالعكس، إذ يغطي المجرم “الداعشي” وجهه ويظهر وجه الضحية، فالمجرم هنا يفتخر بجريمته ويعلنها كما تشير إلى ذلك الفيديوهات المنشورة حول المجزرة حتى الآن. وينتظر الجمهور المزيد من الفيديوهات التي كشفها عنصر صغير من المخابرات بالمصادفة وهو يتسلّم حاسوبًا على أحد الحواجز لـ”تفييش” المارين، ووجد عليه 27 فيديو قام بتسريبها إلى خارج البلاد بكل شجاعة.
وتجدر ملاحظة مدى النفاق والتذلل من قبل أمجد يوسف لمعلمه الذي يبدو أنه ذو رتبة عالية في جهاز المخابرات، أو في أجهزة القصر الجمهوري التي تشرف على مثل هذه الجرائم، التي انتشرت بشكل كثيف ضد السوريين اعتبارًا من مجازر عين البيضا والحولة ومئات المجازر التي سيستغرق الشعب السوري والمحاكم و”الميديا” العالمية عقودًا في البحث والتحري لكشف تفاصيلها.
صعق المشاركون بالجريمة من انكشاف أمرهم بعد اطلاع الصحفية على أرشيف أمجد يوسف واستطاعتها أخذ التفاصيل منه، فقد وجدته يائسًا بعد أن طُرد من المنصب الذي كان يشغله، وخاب أمله من النصر الذي تحقق، واكتفى باستثمار حوالي 30 بيتًا استولى عليها من بيوت المهجّرين من حي التضامن. ولكن شحود استطاعت ببراعة اجتذابهم أيضًا إلى المزيد من الاعترافات التي تدينهم وتدين المؤسسة التي يتبعون لها في بلد “المؤسسات”، كما يقول بشار الأسد ويردد دائمًا.
هذه المجزرة وأمثالها هي التي صنعت النصر لنظام الأسد، وهي التي ساقت السوريين إلى المنافي، وجعلت سوريا بلدًا فاقدًا لاستقلاله لمصلحة الاحتلال الإيراني والروسي.
وإذا كان أمجد يوسف يستثمر جريمته في الاستيلاء على بيوت الغائبين وتأجيرها، فإن غيره يستثمر مع الروس أو مع الإيرانيين، ويساعدهم في توطيد احتلال البلاد واستنزافها وإضفاء الشرعية على احتلالها، ولعل العضو السوري في جائزة المجرم قاسم سليماني العالمية “حسن م يوسف” مجرد مثال من أمثلة كثيرة ممن يتهافتون على كسب المراتب والحظوة عند المحتلين ورعاة المجازر.
التقرير الاستقصائي فيه الكثير من الحرفية ومن العمل الصبور والمتواصل حتى كشف الحقيقة، وهذا درس للناشطين والصحفيين السوريين لمضاعفة الجهد وامتلاك الصبر الذي يؤدي إلى النجاح، وما فعله الصحفيان يوازي فعل دول أو أجهزة دولية في تحريها، فالإيمان بحقوق الإنسان وبكرامة السوريين جديرة بالتضحية.
وفي يوم العيد الحزين هذا، لا نملك إلا أن نوجه الشكر للصحفيين أور أوميت أونغر وأنصار شحود، ولمركز دراسات “الهولوكوست” في جامعة “أمستردام”، ولصحيفة “الجارديان” البريطانية على هذا العمل الشجاع في كشف بعض تفاصيل “الهولوكوست” السوري.
ورغم كل الحزن، كل عام وأنتم جميعًا بخير.
—————————-
ليس النظام السوري وحده في فيديو الغارديان / حازم الأمين
الفيديو الوثيقة الذي نشرته الغارديان والذي يوثق بصرياً إقدام ضابط من جيش النظام السوري على إعدام ٤١ من المعتقلين في العام ٢٠١٣، جاء بموازاة جهد بصري أيضاً، تبذله أقنية تلفزيونية عربية خليجية ومصرية لتقديم صورة مختلفة للنظام في سورية. نحن هنا أمام فيديو وثيقة، في مواجهة مشاهد درامية مفبركة وركيكة وكاذبة، وراء تصوير الأول جندي قرر فضح رئيسه وناشطة اشتغلت على تعقب قصة الضابط المجرم على مدى نحو ست سنوات، ووراء تصوير الثاني نوايا “أنظمة الاستيعاب” في الخليج، وشركات إنتاج لبنانية ومساعي النظام المصري لتعويم قرينه السوري.
تحضر المقارنة بين المشهدين السوريين لتكشف حجم التواطؤ الذي يتعرض له السوريون، فبين فيديو الغارديان وفيديوات المسلسلات الرمضانية يجد المرء نفسه أمام مفارقة مؤلمة فعلاً. مسافة قصيرة جداً بين الحقيقة وبين الكذب، والكذبة هنا لم يرتكبها النظام، ذاك أن الأخير قتل على مرأى من العالم، وهو لا يشعر بالحاجة للنفي أو لافتعال تحقيق أو محاسبة شكلية، الكذبة يرتكبها نظام الرعاية والاحتضان والتعويم العربي والدولي، الذي أشاح بوجهه عن الوثيقة الجديدة، وواصل اتحاف الصائمين بمسلسلات العار التي تبشرنا بعودة سوريا الأسد إلى “الحضن العربي”.
لن يحدث الفيديو الوثيقة انعطافة في المساعي العربية والدولية لتعويم بشار الأسد مجدداً، إلا أنه سينضم إلى “ملفات قيصر” كوثيقة تثقل على ضمائر كثيرة يقظة وتراقب خطوة الاقتراب من نظام الأسد بوصفها سقطة أخلاقية تاريخية سيتم استحضارها على مدى عقود في مواجهة من يدعي أي بعد أخلاقي ينطوي عليه خطابه السياسي.
طبعاً، مواجهة أنظمة الخليج بهذا الادعاء، في سياق تقاربها مع نظام الأسد ليس في مكانه، ذاك أن هذا التقارب ليس بعيداً عن مقولة “إن الطيور على أشكالها تقع”، والأمر بالنسبة إليها لا يتعدى جهداً تبذله لإنتاج مسلسل تلفزيوني يعوزه الخيال والكفاءة، بتقنيات تصوير عالية. لكن هنا يحضر الغرب الصامت على هذا النظام منذ محو باراك أوباما “الخطوط الحمر”، والذي بموازاة صمته يواصل إعلامه فضحاً مكثفاً لجرائم النظام، وهي بالمناسبة تفوق جرائم بوتين في أوكرانيا، وعلى رغم ذلك لم يُبنَ على كل هذا الفضح سوى مراكمة الوثائق والفيديوات في الخزائن.
اذاً على العالم، في سياق “انفتاحه” على النظام في سوريا، أن يشيح بأنظاره عن المجزرة، وعن قصص القتل الموثقة. “الواقعية” القذرة تتطلب ذلك، وقتال “داعش” ومفاوضات فيينا، وإعادة العمل بأنابيب النفط والغاز المتوجهة من الأردن إلى لبنان ربما! النظام يقول للعالم لكي أمرر لكم هذه الرغبات عليكم أن تمرروا لي هذه المجازر. ثمة خلل هنا لن تقتصر تبعاته على السوريين، انما ستمتد إلى دول ومجتمعات ستصيبها قذارة السياسة بوصفها إدارة “واقعية” للمصالح. الشركات الألمانية ستتوجه للاستثمار في ايران بعد توقيع الاتفاق النووي في ظل تواطؤها، لا بل قبولها، بالمجزرة، وفرنسا التي تستعجل التسوية مع النظام، ستصطدم “قيم الجمهورية” فيها بمشاهد المقتلة السورية.
لكن للفيديو وكما للوثائق التي سبقته وظائف تتعدى خيبتنا بالضمير العالمي، فملفات قيصر ما زالت حاضرة في خطاب أخلاقي وثقافي مواز، وهذا الحضور يفضح الصمت مثلما يفضح المرتكب. ومن هنا يبدو الجهد التوثيقي الذي أقدمت عليه الباحثة السورية أنصار شحود بمساعدة الأكاديمي التركي أوغور أوميت أنجور يتعدى في وظائفه سجالاً عابراً كالذي نخوضه مع صمت العالم على جرائم النظام، إلى تثبيت حقائق لن يتمكن أحد من تجاوزها في تأريخه لسوريا ولنظام البعث الذي يحكمها منذ أكثر من خمسة عقود. نحن هنا حيال قتل جماعي معلن، وحيال وجوه المرتكبين وأسمائهم وعناوين سكنهم ونشأتهم، وفي المقابل حيال نظام لا يشعر بالحاجة للإجابة عما جرى، لا بل أن أحداً لم يسأله ولن يسأله. فالأسد يقول للعالم ها أنا ذا، لن أزيح خطوة واحدة عما أنا فيه، ولن أقدم تنازلاً صغيراً للضحايا.
لم يبق أمام السوريين، وهم في معظمهم ضحايا هذا النظام، سوى التعويل على المستقبل لهضم ما أصابهم خلال العقد الفائت. الهزيمة المؤلمة مرفقة بوثائق تشير إلى حجم الجريمة التي ارتكبها “المنتصر”. التعويل هنا على أن هذا “النصر” لن يستقيم، وأنهم ليسوا وحدهم من أصابتهم الهزيمة، بل منظومة قيم تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وفيديو الغارديان هو قرينة جديدة على ذلك.
الحرة
——————————
=======================
تحديث 06 أيار 2022
———————-
سورية.. من المجزرة إلى مرسوم “العفو”/ عمار ديوب
أصيب السوريون بالذهول من بشاعة مجزرة حي التضامن. قتلٌ، ومن ثم حرقٌ للجثث. أيام قليلة وصدر مرسوم عفو رئاسي. ربط كثيرون بين المرسوم والحاجة إلى التغطية على المجزرة. فعلاً، بدأ أهالي المعتقلين بالنزول إلى قلب دمشق النابض بالعروبة، فمن تحت جسر الرئيس، إلى المرجة، إلى قصر العدل، إلى صيدنايا، إلى .. إلى .. الصور المنقولة من وسائل تابعة للنظام: يوميات قذيفة هاون، إذاعة شام إف إم، وغيرها، تقول إن أعداد الأهالي المتجمعين هنا وهناك فاقت الآلاف. ظن الناس أنّهم سيرون أولادهم أخيراً. وتوهموا أن النظام قد يعود إلى رشده، وأن أمهات سينمن وهن يحتضنّ فلذات أكبادهن. لم يحدُث شيء من هذا.
تفيد التقديرات الأولية بأنه جرى الإفراج عن أقل من مائتي معتقل. لا يقدّم النظام أيّة معلومات عن المعتقلين والمغيبين قسراً، ولم يُطلق سراحهم ضمن عملية سياسية تؤدّي إلى طي الحقبة السوداء في عهده منذ 2011. تنتظر عائلاتٌ أولادها منذ أكثر من عشر سنوات، أو أقل بقليل؛ آلامهم التي بثّوها عبر كل منصّة تواصل ممكنة تقول إن الألم المختزن في قلوبهم بحجم سورية كاملة. والمعتقلون ينتمون إلى كل جزء من الجسد السوري، بمناطقه وقومياته. لكن قلة عدد المعتقلين تنفي الربط بين المجزرة ومحاولات التغطية عليها. يُشاع أن النظام شكل هيئة من القضاة منذ فترة، سابقة على المجزرة، للإعداد لـ”العفو”، وربما يكون لذلك صلة بمحاولات إماراتية وجزائرية لشرعنة النظام، نصحته بإصدار بعض المراسيم، كان جديدها مرسوم “العفو” هذا. لكن بعض تلك المراسيم والقوانين أرادت أيضا إظهار “العين الحمراء” للشعب “الموالي” بأن النظام لن يتهاون مع أي انتقاداتِ على وسائل التواصل الاجتماعي؛ عليكم الانتباه جيداً، وإلّا.
يشكل موضوع المعتقلين قضية حساسة لدى شعوب العالم كافة، وما قرأناه وشاهدناه من مقاطع فيديو مسرّبة يجعلنا نتألم بشدة. لم يهتم النظام لأوجاع الأهالي، والأرقام تتحدّث عن أكثر من مائتي ألف معتقل ومغيّب قسرياً، وليس من معلومة واحدة أكيدة عن أماكنهم، وهناك سوق رائجة للسمسرة والنهب مقابل أي معلومة عن أهاليهم ولو كاذبة، فليس للقضاء سلطة فعلية في هذا الملف. والمعتقلون موزّعون بين سجن صيدنايا سيئ الصيت وأقبية الأجهزة الأمنية التي لا تعترف أصلاً بوجودهم، ويمنع الأهالي من مراجعة مكاتبها، والناس أصلاً تتجنّب الذهاب إلى هناك، ما دام الداخل إليها مفقودا، والخارج منها مولودا.
ظنّ السوريون أن الاعتقال طويل الأمد لن يتكرّر بعد الثورة. وفي الأشهر الأولى كان الإفراج بعد وقتٍ قصير عن المتظاهرين، ولكن لاحقاً، أصبح الاعتقال لأشهرٍ، ثم سنواتٍ، ولعقدٍ، وها نحن ننتظر مع الأهالي. اكتشفنا أننا غارقون في الأوهام؛ النظام هو هو، ولم تتغيّر طبيعته الأمنية والاستبدادية، منذ السبعينيات. يبدو تغيير ذلك مرتبطا بتغيير النظام ذاته، وهذا متعذّر. لم تستطع الثورة تغييره، ولم تُرد ذلك الدول المتدخلة بالشأن السوري، الداعمة للنظام والمعادية له على حد سواء.
كان الإفراج عن المعتقلين شرطا سابقا على أي مفاوضاتٍ مع النظام، لاحقا لم تهتم وفود المعارضة المفاوضة للنظام بآلام الأهالي والكوارث التي يعانيها المعتقلون، لصالح مفاوضات “تافهة” عبر اللجنة الدستورية، وفي أستانة، وسوتشي، وجميعها لم تفعل شيئاً بخصوص المعتقلين. مضت السنوات، ولم تحقّق جولات التفاوض إفراجا عن معتقلٍ واحد. وتأكد أن رفض التفاوض مع النظام يشكل موقفاً جادّاً من شأنه أن يفرض قضية المعتقلين على أجندات النظام وحلفائه والمجتمع الدولي. لم يتحقق هذا، والجولة الثامنة من اجتماع اللجنة الدستورية على الأبواب في 28 مايو/ أيار الجاري.
ليس مرسوم العفو الصادر أخيرا، شاملاً، وأية معارضة جادّة كانت ستفعل ما قلناه بكل بساطة؛ فالكلام يدور عن معتقلين سياسيين أو أفرادٍ مدنيين، لا ناقة لهم ولا جمل في العمليات المسلحة مثلاً، أو قاموا بعمليات إرهابية؛ هم بشر كان حظهم سيئا للغاية، إنهم ولدوا في سورية، وكانوا أحياء بعد عام 2011 واعتقلوا. أما دمشق التي عرّفت بأنها “قلب العروبة النابض” لاحتضانها مشروع التحرّر القومي، لم تعد منذ السبعينيات مدينة للأحرار، وتحولت، على يد الأجهزة الأمنية، إلى مدينة تحتضن أشهر المعتقلات العربية وأكثرها رعبا. حتى فلسطين أصبحت اسما لأحد الفروع الأمنية، ولا تزال السجون السورية عالما خفيا وسرّيا، لخصه المفكر السوري طيب تيزيني، حين وصف الدولة السورية بأنها “دولة أمنية”. وبالتالي لا تختزل المسألة في دور الأجهزة الأمنية، بل تتعلق بالدولة بأكملها مذ خضعت لتلك الأجهزة. كيف يمكن لدولةٍ كهذه أن تتصالح مع الشعب؟ كيف يمكنها أن تطلق سراح المعتقلين، وتطوي صفحة التغييب القسري والنظام الشمولي من دون ثورة ضدها، ومن دون ضغوط حقيقية عليها من الداخل أو الخارج. هذا ما لم تفهمه المعارضة، وقد صار لها شأن، بعد أن صارت محمولةً على ثورة، على عكس حالها قبل 2011.
يحق للأهالي احتلال قلب دمشق النابض بالمعتقلين، بحثا عن أولادها، فالناس تريد أن تتصالح مع الحياة، أن تنتهي من التفكير بالمصير الأسود لمن اعتقلوا. كل تجارب الاعتقال في سورية كارثية وجهنمية، ومن حق الناس أن تتعلق بأيّة قشة يظنون أنها قد تعيد لهم أولادهم. الآن، سيصاب الأهالي بالفاجعة من جديد، ولن يهتم النظام لأحوالهم مطلقاً، ولن يبادر إلى “تنظيف” المعتقلات، ولا إلى الإعلان عن مصير المفقودين، ولن يعتذر للشعب، ولن يطيح كبار ضباطه المسؤولين عن الأجهزة الأمنية التي تفنّنت في أشكال الاعتقال والتعذيب والقتل، ومجزرة التضامن ليست أولها ولا آخرها.
ألم استمرار احتجاز المعتقلين يفرض على المعارضة وكل المؤثرين في الشأن السوري رفض أيّ تفاوض مع النظام، قبل طيِّ صفحة الاعتقال والمعتقلين. لا ينبغي أن يكون هناك تنازل عن هذا الحقّ، فلا حلّ في سورية طالما بقي قلب دمشق ينبض بالمعتقلين ومعاناتهم، وخيبات أمال ذويهم، في مسلسلٍ مستمرٍّ من قتل ورعب.
العربي الجديد
—————————–
صور من بيت الموتى السوريين/ بشير البكر
أراد النظام السوري أن يغطّي حفرة حي التضامن، ويحرف الاهتمام المركّز، محليا وخارجيا، على جريمة إعدام جماعي لـ41 مدنيا وإحراق جثثهم، بإصدار قرار عفو عام عمّا يسميها جرائم الإرهاب، والإفراج عن عشرات المعتقلين. واختار توقيت عيد الفطر كي يخلط الأوراق، وفي ظنّه أن فرحة بعضهم بعودة أولادهم من بيت الموتى سوف تطغى على أحزان وآلام المنكوبين من أهالي ضحايا مجزرة حي التضامن، الذين تعرّف عليهم بعض ذويهم من الصور التي تسرّبت، ومنهم الفلسطيني من أبناء مخيم اليرموك وسيم عمر صيام، الذي كان قد خرج لشراء أسطوانة غاز ولم يعد، ويبدو أن الحاجز القريب من منطقته استوقفه وساقه إلى هناك من دون تهمة محدّدة. ومثل هذا الرجل كثيرون اعتقلتهم أجهزة النظام، وصاروا في عداد المختفين قسريا، ومن بين هؤلاء سوريون وفلسطينيون، لم توثّق الهيئات المختصّة أسماءهم. وبالتالي، لا يعرف أحد عنهم شيئا، وتبيّن، من عملية الإفراجات الأخيرة، أن هناك سجناء مجهولون لجهة أسباب الاعتقال وظروفه، وبعض هؤلاء فقد الذاكرة في السجن.
الصور هي التي فضحت النظام، بينما أراد منها أن تغطّي على الحفرة، وكشفت أنها على اتساع المقبرة الجماعية السورية المفتوحة وعمقها ومداها. وخلال أيام العيد، تحولت صور الأهالي المنتظرين تحت الجسر من حالة انتظار الفرج والإفراج عن المعتقلين إلى عزاء جماعي، ولقاء للمكلومين الذين يترقبون منذ سنوات عودة أبناء، وأزواج، وأشقاء، وأقارب. تجمهروا بالآلاف تحت الجسر في حي الميدان وسط دمشق المعروف بجسر الرئيس، وصار اسمه لدى السوريين جسر الكلب. ومن بين اللقطات القاسية التي تداولتها وسائل التواصل رجل يعرض صورة شقيقه المعتقل على أحد المفرَج عنهم، مستفسرا عما إذا التقى صاحب الصورة في السجن أو شاهده، وكانت المفاجأة أنه هو الشخص المعني، ولكثرة ما لقيه من أهوال في السجن لم يتعرف عليه شقيقه، ولكن المفقود العائد من بيت الموتى تعرّف على صورته التي يعود عمرها إلى عشر سنوات، وهناك صور أخرى كثيرة وثقتها كاميرات الهواتف النقالة، وعرفت طريقها إلى وسائل التواصل، لتشكّل مجتمعة ألبوما للرعب في سجون آل الأسد. وكل واحدة منها رواية عما وراء القضبان، من تعذيب وتحطيم للسورين الذين حلموا بالحرية، ومرآة تعكس وجه هذا النظام الذي لم يترك أيا من أنواع الجريمة لم يرتكبه، وتجسّد قسماته وآثاره الموجودة في كل مكان. وأكثر ما تفصح عنه حالات وجوه الذين عادوا من سجون الأسد وتعابيرهم، وما تقوله صورهم وأشكالهم وردود أفعالهم، أنهم كانوا مدفونين تحت الأرض في مكان بعيدا جدا، ولكن أجسادهم لم تتحلل، لأن أرواحهم جديرة بالحياة والكرامة.
هناك 86792 مخفيا قسريا لدى النظام منذ مارس/ آذار 2011، بينهم 1738 طفلاً و4966 امرأة، موثقة أسماؤهم لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجرى رفع قضيتهم أكثر من مرة إلى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة، ونصّ قرار مجلس الأمن 2254 على ضرورة الإفراج عنهم من أجل تسهيل المفاوضات بين النظام والمعارضة، ولكن النظام لم يلتزم، بل إنه يفرج بين حين وآخر عن بعض الجثث، كما حصل في فبراير/ شباط الماضي عندما سلم أهالي 54 مفقودا من بلدة دير العصافير عبر السجل المدني إشعاراتٍ تقرّ بوفاتهم في السجون، ليرتفع عدد الذين اعترف بموتهم إلى 1056 منذ مطلع 2018. وهذا لا يعني أن هذا هو العدد النهائي للوفيات التي لم يعترف النظام بها كلها، وما وثقه قيصر وحده هو 6860 قتيلاً من بين 55 ألف صورة قام بتهريبها، لتشكل شهادة على جريمة إبادة لا مثيل منذ جرائم هتلر وستالين.
العربي الجديد
——————————
الحقيقة المغيّبة في سورية/ جمانة فرحات
على مدى أكثر من عقد من عمر الثورة السورية، رُوي الكثير عن مجازر نظام الأسد. كذلك وثِّقت مجازر بالصوت والصورة. بالرصاص والكيماوي والبراميل المتفجّرة. لم يترك النظام وسيلة يمكن استخدامها لقتل السوريين ولم يجرّبها. بدا أن سورية كلها ساحة اختبار متاحة له.
لكن ما يظهر كان دائماً جزءاً ضئيلاً من حجم الجرائم المرتكبة. ذهبت بعض الشهادات مع من قتلوا على أيدي النظام وعصاباته، وبعضها الآخر لم يخرج إلى العلن، لأن هناك من لم يجرؤ على سرد ما عايشه من لحظات الرعب والموت. لكن جزءاً آخر ويسيراً من هذه الجرائم جرى الحديث عنه ولم يأخذ حقه في النشر والتحقيق والتوثيق. ولذلك عندما خرجت تفاصيل مجزرة حي التضامن التي توثق إعدام عشرات المدنيين ميدانياً وحرق جثثهم، فإنها لم تكن جديدة بالنسبة لأبناء المنطقة، فقد كانوا يعرفون جيداً ما كان يجري في أحيائهم على أيدي عناصر أمن النظام وشبّيحته.
مع ذلك، فإن الفيديو المسرّب للمجزرة، بنسخته التي نشرتها صحيفة الغارديان، والتي تخفي فيه وجوه الضحايا، كان صادماً لهم. صحيحٌ أن الفيديو أظهر بوضوح هوية الجناة ولا مبالاتهم، لكن الأهم أنه وثّق بعضاً من آخر لحظات الضحايا. أما النسخة الثانية الخالية من أي تقطيع أو إخفاء للوجوه بدقائقها التي تقارب السبع، وتظهر فيها حفرة الموت بوضوح، وأصوات الضحايا قبل أن يُدفعوا إليها، وأنفاسهم ونظراتهم الأخيرة قبل إطلاق الرصاص نحوهم ليتكدّسوا فوق بعضهم بعضا جثثاً هامدة فكانت الأقسى، كأنها الجحيم. إنها من بين أكثر الصور تعبيراً عن عمق إجرام هذا النظام الذي لا يتردّد في إعدام العشرات ميدانياً وحرق جثثهم.
على الأرجح، هناك مئات العائلات، إن لم يكن الآلاف، ممن فقدت أبناءها خلال تلك الفترة من عمر الحرب في تلك المنطقة تحديداً، وجدت نفسها مضطرّة لمشاهدة الفيديو أكثر من مرّة لقطع الشك باليقين، ومحاولة تحديد مصير مفقوديها. ويمكن تصوّر هول المعاناة وهي تدقق في الوجوه وتتصوّر مصيراً مشابهاً لأبنائها المخفيين ممن لم تظهر أي معلومة عنهم طوال السنوات الماضية.
تحقيق المجزرة بتفاصيله الكثيرة والفيديو المسرّب كأنهما شرارة أذنت لاستعادة ما في ذاكرة السوريين من مآس، وإعادتها إلى الحيز العام. بدا كأن المجزرة أعادت تشغيل ذلك الشريط المحفور في الذاكرة، والذي يأبى النسيان أو التجاوز بالنسبة لعائلات الضحايا، ولم يكن يحظى بما يستحق من اهتمام إعلامياً.
كان هناك عشرات على الأقل ممن لديهم تفاصيل لو مشتّتة، عما جرى تلك الفترة. أعادوا نشر تدويناتٍ قديمة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنهم يقولون “ألم نحدّثكم” أو استذكار تفاصيل تلك الفترة وقصص ضحايا خرجوا من منازلهم ولم يعودوا إليها يوماً.
ليس مبالغة القول إن أي بيت سوري اليوم لا يخلو من مأساة موقعة باسم النظام، سواء على هيئة قتلى أو معتقلين أو مخفيين أو منفيين. تمتد المأساة داخل سورية وخارجها، ولن يكون تجاوزها ممكناً. بعد سنة أو عشر سنوات أو 20 سنة، وحدها الحقيقة ستبقى المطلب الأساسي للعائلات. والحقيقة غير مطروحة بالنسبة إليهم واحدا من من بنود العدالة الانتقالية تتيح إنجاز المصالحة، أو تندرج ضمن حقهم في الإنصاف أو التعويض .. فذلك حديث لزمن آخر. الحقيقة بالنسبة إليهم هي مجرّد امتلاك معلومة دقيقة، مهما كانت مؤلمة عن ذويهم، تتيح لهم التعايش مع الواقع عوضا عن اضطرارهم للتعامل مع حالة اللايقين، ما يُبقي جروحهم مفتوحة، وتتجدّد معاناتهم مع كل مجزرة جديدة يتم اكتشافها.
العربي الجديد
————————–

أمجد يوسف في “قرابين التضامن”.. العلوي المسيّج بالخوف/ مصلح مصلح
لا يمكن لمشاهد مقطع فيديو مذبحة التضامن الذي يظهر فيه المخابراتي أمجد يوسف وهو يمسرح عملية قتله لمجموعة من الناس السوريين الأبرياء إلا أن يسقط فريسة لمشاعر متناقضة؛ التعاطف مع البراءة، براءة أناس يمضون إلى حتفهم بكل وداعة القرابين الطيبة. الفجيعة، الاعتداء على الوجود الإنساني مرتين، مرة عبر هدر قيمة الحياة ذاتها، مقايضة حياة أناس من لحم ودم بطلقة تافهة من النقطة صفر، ومرة أخرى عبر الإصرار على المحو، أن تحوْلَ الحفرة المعبئة بالنار والحقد والرماد بين أجساد الضحايا وبرزخها، النافذة الوحيدة المتروكة أمام الموتى للإنصات إلى نداء القيامة المدوخ.
ومن ثم ليجد نفسه وجهًا لوجه أمام مشاعر الغضب الأكبر، من أعطى الحق لهؤلاء الأوباش الآدميين أن يصيروا في طرفة عين آلهة، في أن يختطفوا الله، ينتحلون قدرته، يعبثون بأحجار القدر ونواميسه المتعالية؟ إزاء كل هذا العبث المفجع، يتساءل المرء عن جدوى الاحتجاج، عن جدوى المعرفة، معرفة الشر ونكهة الشرير، غير تلك الصرخة المكبوتة: “يا إلهي، أي نوع من البشر أنت يا أمجد! من أين جاء شرّك المستطير هذا إلى الوجود، وإلى أين سيمضي؟”.
أمجد بين أسطورة الشرير الوحش… والشرير التافه
في بحث المرء عن طبيعة الشر عن كنه الشرير الذي صاره أمجد، لا يذهب بعيدًا، فالرجل حاضر في ردة فعله حين جوبه بحقيقة دوره في المذبحة. ليكتشف أنه أمام إنسان طبيعي من لحم ودم، إلى الدرجة التي قد يصاب بالذهول من هول ما ارتكبت يداه، وربما تعداه الأمر لأن يصاب بالقشعريرة في كامل جسده، حد تفكيره الفرار من صدمتها المروعة عبر بوابات اللامكان. فمن ذلك الأمجد الذي يرضى بتسليم رقبته للسياف أو جسده للنار التي أوقدها في جثامين ضحاياه، لذا نراه يتنصل من فعله الجرمي “أقتل، لا! مستحيل، كل ما في الأمر إني كنت أقوم باعتقال مطلوبًا ما لا غير”. إنّ سلوكه طبيعي وطبيعي جدًا! أليست هذه ردة فعل الجاني الطبيعية حين يقف وجهًا لوجه أمام محققيه أو قضاته المشتعلين غضبًا؟ أليست هذه ردة الفعل الطبيعية من قبل أي جاني قد يجد نفسه عرضة لخطر القصاص حد الموت، فلا يجد من وسيلة للدفاع عن حقه في الحياة سوى الاحتماء بهرمونات الجسد ومفرزاته.
من الإنكار “لا لم أفعلها!”، إلى الاعتراف “نعم هو أنا بشحمه ولحمه”، ومنه إلى الاعتراف التبريري مرة أخرى “نعم لقد فعلتها، ولكن”. كيف يمكن لنا قراءة ردة فعله المتأرجحة بين الإنكار والاعتراف المصحوب بالتبرير. لا شيء جديد في سلوك أمجد فهذا ينتمي إلى الطبيعي أيضًا، ينكر كي يفلت من العقاب الذي قد يطاله، ولكن حين يدرك أنه أمام ذلك النوع من الأدلة التي لا يفيد فيها الإنكار، وإن ما لدى محاوره ليس مجرد لقطة، بل يتعداه إلى كامل شريط المذبحة، يسقط في يديه “نعم فعلتها”، ولكن لا تنسي، موجهًا خطابه إلى محاورته الافتراضية “آنّا”، إنه ليس أمرًا شخصيًا، لا تنسي أنني كنت في الجيش، وهذا جزء من مهمتي”. هل كان أمجد يخاف نظرة اللوم والعتب في عيون محاورته “آنّا”، وأنه كان يدافع عن وضعيته اللانسانية التي قد تقذف به إلى خانة الوحوش الآدميين والقتلة المتسلسلين العديمي الإحساس والضمير؟ لربما! إذا كان إنكاره وتبريره اللاحق ينتميان إلى الطبيعي، بالنظر إليهما كدفاع عن أحقية انتمائه إلى الوجود البشري، فما الذي دفعه بعد هذه المرافعة المبهرة، ، بالعودة إلى ما يضادها، البهيمة “أنا فخور باللي عملتو”!
لا شك إن موقف أمجد من جريمته يبلبلنا، ذلك أنه في اللحظة التي يلعن تبرؤه منها “لقد كنت جنديًا في الجيش”، يعاود الاحتفاء بها على نحو جذل “أنا فخور باللي عملتو”، الأمر الذي يجعلنا متشتتين روحيًا في فهم دوافع فعله الجرمي ومن ثم طبيعة شره الآدمي. هل نحسب شره المستطير على فئة عتاة المجرمين الذين يرتكبون أفعالهم الجرمية عن سابق إصرار وترصد ودون أي علامة من علامات الإكراه والضغط؟ أم نحسبه على فئة الأشرار التافهين، الذين يؤدون أعمالهم الجرمية بكل كسلهم الاعتيادي المصاحب لاحتسائهم فنجان من القهوة؟
يتقاطع موقف أمجد في رغبته بإنكار جريمته المهولة وتحميل وزرها لمن هم في قيادة الجيش أو قيادته السياسية، مع موقف الضباط النازي أدولف إيخمان، المتهم بإشرافه المباشر على برنامج التطهير العرقي بحق يهود أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، الذي استمات في نفي صفة “مذنب”عنه، وتحميل وزرها إلى رؤسائه في هرم القيادة النازية، الأمر الذي وجدت فيه حنة أرندت مدخلًا جديدًا لفهم شره المستطير ذلك، الذي أودى بحياة ملايين البشر. عبر رده إلى النوع من الشر التافه أو السطحي في رغبة عميقة منها بإقامة التعارض بين الخير والشر، في رد الخير إلى العميق والجذري وفي رد الأخير الشر إلى السطحي والتافه. دون أن يفهم من حديثها عن تفاهة الشر بكونه غير خطر أو مؤذٍ أو مدمر. فمعنى أن يكون الشر تفاهًا أو سطحيًا، وفق رؤية أرندت، فهو محاولة عقلية منها بنسبته للطرفي والسطحي والطارئ والوحشي معًا، على الضد من كل ما هو إنساني وعميق وجذري.
فما الذي يمكن إدانته في سلوك إيخمان كما ذهبت أرندت، ما دامه يصر على نفي التهم الموجه له “لست بمذنب”، على نفي وجود إرادة حرة لديه، على نيته أو قصده الجرمي بإلحاق الأذى بالآخرين؟ وكيف يفعل كما يدعي، وهو لم يقم مع ضحاياه المفترضين علاقة شخصية أو عدوانية؟ أضف إلى ذلك كله؛ جهله التام بأسمائهم كما عناوينهم ومشاعرهم الإنسانية، حيث لم يتسنَ له أن التقى بأحد منهم، فكل ما في حوزته عنهم مجرد أرقام، تحتاج إلى التخزين والتبويب والمعالجة.
كان يمكن لشر أمجد وفق تحليل أرندت أن يظل تافهًا، فما البطولي بشخص يتنكر لإرادته الحرة، ويدعي أنه كان مجرد جندي في الجيش، لولا أن الطبيعة الحميمة التي أقامها الرجل مع ضحاياه تنفي كل ذلك. فهو وإن لم يكن يعرفهم عن قرب كجيران، فقد اقترب منهم إلى مسافة جعلته يحصي عليهم أنفاسهم، مما لا شك فيه أنه غرس عينيه في عيونهم وتأمل مدى صلاحية كل منهم قبل ضمه إلى لائحة قرابينه المقدسة، هذا لجهة المشاعر وحدها. أما لجهة الإرادة الحرة، فقد أثبت أنه صاحب إرادة حرة بالكامل، فلم يكن الرجل ينفذ عمليات الإبادة في ظل ظروف قسرية تتخطى إرادته، كما لم يكن كما صرح مجرد أداة لتنفيذ قرار سياسي بالإبادة على الرغم من وجود مثل هذا القرار. على العكس من ذلك كله، فقد كان الرجل يمارس التصفية لحسابه الشخصي، ألا يكفيه شرفًا أنه كان ينتقم لمقتل أخيه نعيم (الذي سقط شهيدًا على يد العصابات الإرهابية في داريا 2013). الأمر الذي لا يدع مجالًا للشك في تصنيف شره ضمن دائرة الشر “المطلق والجذري”، الذي لا يصدر إلا عن شخص لديه كل الدوافع الشخصية، كما كل الإرادة الحرة، ليحجز لنفسه موقعًا متقدمًا في صف الشر الأعظم، من وجهة نظرنا، وفي صف البطولة القصوى من وجهة نظر محازبيه وأنصاره.
قرابين مقدسة أم قتل طائفي على الهوية؟
من ناحية الشكل أو السياق التي ارتكب فيه أمجد جرائمه، لا يملك المرء أدنى تشكيك في صدقية الرجل، لناحية تعامله مع ضحاياه كقرابين، حيث كل الدلائل تشير إلى أنه لم يتعامل معها خارج الإطار الطقسي لمفهوم الأضحية، بمعناها السحري لا الديني، حيث أن هدفه كان منصبًا على تحقيق راحة روح أخيه نعيم، لا على نيل رضى الآلهة أو تصريف العنف خارج الجماعة التي ينتمي إليها، كما هو الحال في وضعية التضحية البشرية أو الحيوانية.
إذا قال أمجد إنه لم يكن يقتل بل كان يضحي علينا أن نصدقه، فهو في وضعيته تلك لا يخرج عن وضعية شامان القبيلة أو ساحرها الأكبر. إن هدفه ليس القتل ذاته كما يعكس سلوكه الطقسي بل الإرضاء، إرضاء روح أخيه الباحثة عن الراحة، وإلا لبقيت هذه الروح في حالة من الضياع الكلي، الذي لن يمكنها من الصعود إلى بيت الأرواح. إنه لا يقتل بل يمارس طقسًا سحريًا، كي تحصل أو تنال روح معذبة وبرئية مثل روح نعيم على رضاها. كان لابد لها من أن ترضى، ولكي ترضى كان لا بد لها من قرابين بريئة على شاكلتها، بشرط أن تقدم هذه القرابين على نفس الصورة التي فقد فيها نعيم حياته، القنص. إن أمجد لا يقتل إنه يضحي، إنه لا ينحر أحدًا بل يقنص، الأمر الذي يتطلب تحقيقه طيرانًا ما من الضحية، أليست هذه وظيفة الحفرة الطقسية، كما هي وظيفه الرصاصة اليتيمة التي تخترق جماجم الضحايا؟
ولكن على المقلب الآخر من المشهد، كيف لنا أن نصدق أن أمجد لم يكن قاتلًا هويّاتيًا، صاحب هوية، وهو يصر على أن يكون جميع ضحاياه من أبناء هوية واحدة، أو على نحو أدق من جماعة من جماعة دينية أو طائفية واحدة، السنّية تحديدًا، وإلا ما الذي يجمع الفلسطيني وسيم صيام ابن مخيم اليرموك، مع التركماني شامان الضاهر، ابن حي التضامن، رغم القرب الجغرافي بين حيهما سوى البراءة والانتماء العقيدي المشترك؟ الأمر الذي يدعونا إلى الذهاب عميقًا في التحقق من الفرضية القائلة بأن سلوك أمجد الإجرامي لم يكن نابعًا من حرقة قلب على أخيه الفقيد، بل من موقف عقائدي ذي منشأ نفسي له علاقة تاريخية بعلاقة الطائفة العلوية مع الطائفة السنية.
الطائفة العلوية.. الخوف الوجودي
في كتابه “دائرة الخوف، العلويون السوريون بين الحرب والسلم” يجادل الباحث ليون غولد سميث، بأن العامل الجوهري الذي ظل يتحكم في سلوك العلويين منذ نشأتهم في المعازل الجبلية مع جيرانهم هو الخوف، خوفهم من المحيط وخوف المحيط منهم عبر اتهامه لهم بالتآمر. فالعلويون لم يكونوا مجرد طائفة باطنية من طوائف الاسلام، التي يبحث أنصارها عن ملجأ روحي وحسب، بل كانوا أصحاب مشاريع سياسية. إلا أن قدرتهم على الفاعلية السياسة، كالتمتع بالاستقلال الذاتي ظلت محدودة في ظل حكم سلالات حكم قوية كالمماليك والعثمانيين.
يمكن القول إن أول بادرة للاندماج العلوي مع محيطه السني في سوريا يعود إلى العام 1936، على الرغم من أن الاندماج الحقيقي ضمن ما يسمى بسوريا الحالية قد تأخر إلى عام 1946 بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. أدى انخراط العلويين في الدولة السورية الحديثة ومن ثم نيلهم الاعتراف بانتمائهم إلى أحد المذاهب الإسلامية الكبرى، الاثني عشرية، إلى تهدئة مخاوفهم من الإبادة، كما أدى في الوقت نفسه إلى إضعاف عصبيتهم الطائفية. ولكن سيثبت انقلاب 1963 البعثي الذي خطط له وقاده ثلة من العلويين السوريين في الجيش (محمد عمران، صلاح جديد، حافظ الأسد) أن الاحباط العلوي من الاندماج عبر ضعف تمثيلهم السياسي والاجتماعي، سيشكل الشرارة التي ستطلق العصبية الطائفية التي خبت جذوتها في الفترات السابقة.
وفق المنطق الخلدوني لتشيكل السلالات الحاكمة، لا يمكن فهم التحالف السياسي الذي نشأ بين حافظ الأسد والعلويين 1973 إلا ضمن رغبة الطرفين في الاسثمار بهذه العلاقة. رغبة حافط الأسد بتأسيس سلالة عائلية حاكمية، تقوم على الاستبداد واحتكار السلطة، وبين رغبة العلوين بالترقي الاجتماعي والفعالية السياسية، وتحقيق الاندماج الحقيقي في المجتمع السوري.
نجح كلا الطرفين المتحالفين في تضخيم نتائج تحالفهما، وقد أثبتت الاحتجاجات السنية 1976 – 1982، الناتجة عن الإحباط السياسي واستفراد الأسد بالسلطة، على متانة تلك العلاقة بينهما، كما أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك بأن استمرار حكم حافظ الأسد الاستبدادي متوقف على الدعم الكامل من قبل أبناء “العصبة العلوية”.
ومع أنه يمكن التشكيك بالقول القائل بأن النظام الأسدي في سوريا لم يكن يومًا “نظامًا علويًا”، لجهة أنه لم يصمم لخدمة مصالح العلويين بقدر ما صمم لخدمة حكم آل الأسد، ومجموعة صغيرة محيطة به، فإن هذا الحكم ينطبق أكثر على فترة حكم الأسد الأب، الذي كان عليه أن يراعي مصالح العلويين أكثر من غيرهم حتى يستطيع تثبيت حكمه السلالي.
مع قدوم بشار الأسد إلى السلطة سوف يطيح الرجل بثنائية العلاقة تلك، وسوف تأخذه العزة بالإثم بنسب مجده الحالي، أي تربعه على كرسي السلطة، إلى ذكائه وشطارته وحدها، متناسيًا عن عمد كل علاقة تحالفية له تذكر مع الناس الذين أوصلوه إلى سدة الحكم العائلي. وللتدليل على ذلك سوف يقطع مع جميع أساليب النهب، التي كانت تسمح له بتقاسم الغنائم معهم ، ليخص بها نفسه وحدها، دون أن يتغافل عن التسامح مع وجود دائرة ضيقة من المنتفعين الذين لن يتجاوز عددهم الـ 500 شخص.
في عام 2011، تحديدا مع بداية الثورة السورية، ظهرت لدى العلويين فرصة سانحة لقطع علاقتهم مع الاستبداد، عبر توجيه أبنائهم إلى رفض إطلاق النار على المحتجين السوريين. إلا أنهم تصرفوا على عكس من المأمول، فما الذي منعهم من فعل ذلك؟ لا شك أن انتماء البعض منهم إلى مؤسسات الجيش والمخابرات كما المؤسسات الحكومية قد أثر على قرارهم، كونه يشكل تهديدًا على مستويين لهم؛ فقدان مصدر رزقهم من جهة، وفقدان مكانتهم السلطوية التي يتمتعون بها بين الناس.
وإن كان للمرء أن يتفهم أثر العوامل النفسية لدى الأفراد أو الجماعات عند اتخاذهم للقرارات المصيرية التي تمس وجودهم الوظيفي والسلطوي، إلا أن ذلك سوف يضعه أمام تحد معرفي، لفهم التصرفات أو المواقف التي يتخذها الناس العلويين العاديين ضد مصالحهم الشخصية، وهي قبولهم الطوعي للعب دور المحافظ على سلالة آل الأسد، التي لا تقيم لمصالحهم أي إعتبار.
الخوف، الخوف الطائفي تحديدًا، ربما يكون هو كلمة السر التي أدت إلى انخراط العلويين في آلة الأسد الدموية. فلقد شعرت الأغلبية الكاسحة أنها مهددة بوجودها الشخصي، وكيف لا تفعل وهي ترى حركة الاحتجاجات تخرج من الجوامع. فلقد ربط العلوي الخائف لا شعوريًا بين الجامع وحالة الاضطهاد الطائفية التي مر بها أسلافه عبر مئات السنين. وعنت له حركة الجماهير السلمية شيئًا واحدًا، التنكيل به ودفعه إلى المعازل الجغرافية التي عاش فيها أجداده قرونًا. وحده النظام من كان واعيًا لهذا الخوف الطائفي لتحصين نفسه من السقوط، لذا نراه يعمد إلى تبني هذه الاستراتيجة في خطة عمله لقمع الثورة، عبر تقديم فعاليتها إلى مناصريه العلويين كحركة عنف مرتبطة بالإرهاب الطائفي، السني تحديدًا.
بين الردع والانتقام
إن أي فهم لسلوك أمجد يوسف لا يأخذ بعين الاعتبار عمق خوفه الطائفي، لن يسمح بفهم الرابط الذي يقيمه الرجل بين الطقسي المتعلق بالانتقام، وبين الإبادة الجماعية المتربطة بالخوف الوجودي. فإذا أخذنا سلوك أمجد في كونه فعلًا سحريًا، فإننا لن نجد فيه ما يغري سوى طابعه الطقسي، الممهور بلمسة متعمدة من القسوة لتطهير مخاوفه عبر النار. أما إذا تعاملنا معه بأنه موقف يتجاوز الانتقام الشخصي إلى الانتقام الجمعي، الهوياتي (من هوية)، فعندها نكون في موقف من يمكننا فهم سلوكه الذي يجمع بين الانتقام والردع.
يتقاطع السلوك الانتقامي لأمجد في مذبحة التضامن مع السلوك الانتقامي للبدوي في خاصية جوهرية، تتعلق بتعامل كليهما مع الأعداء المفترضين كجسد، حيث لا فرق هناك بين هوية القاتل الفعلي أو أخيه أو ابن عمه، أو أي فرد من أفراد القبيلة، ما دام الجميع في عرف المنتقم مجرد تنويع جسدي لمطرح واحد هو جسد القبيلة. من هنا يمكن فهم سلوك أمجد الخاص باختيار ضحاياه من جسد القبيلة الأكبر، القبيلة السنية.
ومع ذلك فإن موقف أمجد النفسي يتفوق على الموقف النفسي عند البدوي الراغب بالانتقام، لجهة تخطيه لمفهوم الردع الذي يسعى لتحقيقه البدوي من عملية انتقامه تلك. أما هدف أمجد من الانتقام فهو أكثر غورًا، إنه لا يقتل ليردع وحسب، بل ليبيد. وهو إذ يفعل ذلك لإحساسه العارم أنه مهدد وجوديًا بالفناء من قبل الآخرين، السنة تحديدًا. وللتدليل على وعيه العارم بالإبادة والإفناء، فإنه لا يقصر انتقامه على ذكور القبيلة، وإنما يمده ليشمل نساءها أيضًا، أليس النساء هن رحم القبيلة الولود؟ كما إلى الأطفال والشيوخ معًا، أليس الأطفال مشاريع خطر وجودي لاحق؟ وأن الشيوخ صلة الوصل بين ما مضى وما سيأتي، ألا يستحقون الإبادة بأثر رجعي؟
أثبتت تعليقات الاستحسان الموالية التي امتدحت سلوك أمجد، أن هناك أكثر من أمجد واحد بين ظهرانينا، وإن مجرد ظهوره من عدمه يظل قائمًا على الصدفة وحدها، ذلك أن العوامل النفسية المهيئة لارتكاب المذبحة واحدة، إنها الخوف الوجودي من الآخر. لا شك أن ردود الأفعال السابقة تلك مرعبة، الأمر الذي حدا بأحد الإعلاميين بالتحذير منها واستنكارها، إلا أنه في حمى ذلك الرعب لم ينس أن يشير إلى رعبه من العنف اللفظي السني، الذي يصر على وضع كل أبناء الطائفة العلوية أو كل علوي منهم في موضع المتهم أو المسؤول عن جرائم لم يرتكبها ولا يقر بها بأية حال من الأحوال.
واحدة من الدفاعات الأولية التي أظهرها المحتجون على بشاعة مذبحة التضامن، هو إشهارهم لفعل التذكر “لن ننسى، لن نسامح، لن نصالح”. إذا كان الكلام موجهًا إلى حكم آل الأسد السلالي بقصد عدم التخلي عن فضح الطبيعة الدموية لنظامه، كما الإصرار على تقديم مجرميه إلى المحاكم الدولية، فهذا أمر حسن ومقبول. أم إذا كان الكلام موجهًا للعلويين كطائفة والتشنيع عليهم “الطائفة القاتلة” فهذا مدان وخطير في آن، كونه لا يسهم سوى في دفع المحتج للعب في ملعب الأسد نفسه، الذي يرى في الردح الطائفي الدجاجة الذهبية التي تحمي حكمه السلالي من الانقراض.
إن الخروج من هذه المعمعة المعبأة بالعنف الطائفي المرتكز على العنف الوجودي، هو دعوة الطائفة العلوية لفك ارتباطها بالحكم السلالي الاستبدادي لآل الأسد. فلقد أثبتت وقائع الثورة السورية أن الأسد ليس بالمؤتمن على أمنها ومصالحها، بقدر ما هو المتسبب الحقيقي بهدر دم أبنائها. لقد كان هدف العلويين الأكبر منذ 1936 الاندماج المجتمعي ودخولهم في علاقة مواطنة مؤسسة على حكم القانون. فليتمعنوا بما جنوه من تحالفهم الشيطاني هذا مع الأسد، وليتمعن أعداؤهم المعبئون بشحنات العنف الطائفي المضاد، التي لن تفيد أحدًا من السوريين سوى استمرارهم العيش ضمن مشهدية المقتلة الكبرى
الترا صوت
—————————–
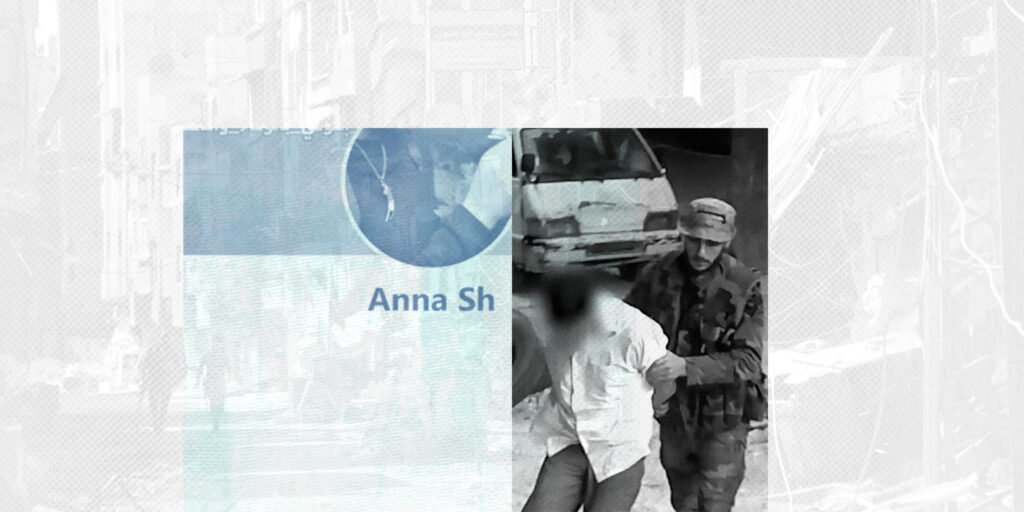
مجزرة التضامن: أنصار شحّود وأور أوميت أونغر يرويان لـ”العربي الجديد” تفاصيل التحقيق
ديمة ونوس
لم تعرف أنصار شحّود أنها إن تركت مدينتها المدمّرة حمص في العام 2013 متّجهة إلى بيروت، ستعثر على نفسها بعد سنتين فقط في جامعة أمستردام.
إلا أن تلك الرحلة تبدو بديهية أو منطقية، وكأن نفقاً حُفر بين حمص، حيث مارس النظام السوري كل أنواع الإجرام، من المجازر إلى الاعتقالات والقصف والترويع و”التطهير”، وبين قسم دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية.
إلا أن تلك اللحظة المنطقية والواعية ستنجلي مع لقائها البروفيسور في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة أمستردام أور أوميت أونغر، وبدء تحضيرها لماجستير في الجامعة عن عنف الدولة في سورية.
كل ما ستعيشه أنصار لاحقاً برفقة أور سيكون عبثياً، بالضبط كما هو حال بلدها الذي فتّته النظام، وجعله حفرة كبيرة تمتدّ على كل مناطق نفوذه. هناك، تُرمى أجساد تتطاير في الهواء قبل أن يُسكتها الرصاص وتُخفي ملامحها النيران، وكأن شيئاً لم يكن.
الدراسة المطوّلة التي عمل عليها الباحثان، ونُشرت بالعربية والإنكليزية تزامناً مع تسريب فيديو مريع عن “مجزرة التضامن”، تطرح العديد من الأسئلة. إلا أنها تجيب أيضاً عن العديد منها، وتفتح النقاش مجدّداً حول نظام ارتكب، على مرّ السنوات العشر الماضية، أفظع الجرائم وأبشع الانتهاكات، من دون محاسبة أو عقاب، في الوقت الذي بدأت فيه دول عربية عديدة تطبيع علاقاتها معه، وفي الوقت الذي تعيد فيه دول غربية كثيرة حساباتها مع قضية اللاجئين السوريين وملف الهجرة بشكل عام.
قبل أشهر من تسريب هذا الفيديو المرعب اعتبرت الدنمارك أن دمشق “منطقة آمنة”. فهل إعادة فتح الحفرة السورية ستدفع الدول إلى إعادة النظر في تلك القضايا؟ يقول الباحث أور أوميت أونغر، في لقاء مع “العربي الجديد”، إنه ليس متفائلاً بالعدالة الانتقالية، لأن النظام قوي، ولا نرى حماسة لدى أي من الدول الغربية لوضع حدّ لهذه المأساة، منتقداً الدول العربية وبعض دول الجوار التي ترى أن الحل في سورية دبلوماسي.
إلا أنه في الوقت ذاته يبدي تفاؤله بجدوى الدراسة التي أعدّها مع زميلته أنصار شحّود في وقف أي محاولة، أو نية لترحيل اللاجئين السوريين.
معلومات موثقة عن أشخاص قتلوا
ويقول أور: “الدنمارك تقول إن دمشق “منطقة آمنة” اليوم، وربما لن تعيد النظر في رأيها هذا بعد تسريب فيديو “مجزرة التضامن”، لأن تاريخه يعود للعام 2013. إلا أن أمجد (يوسف) لا يزال هناك، وفروع المخابرات كذلك وأعوانها و”شبّيحتها”. وإن لم تكن هناك فيديوهات مسرّبة، فهذا لا يعني على الإطلاق عدم وجود مجازر وجرائم ترتكب حتى هذه اللحظة! ثمة معلومات موثقة عن أشخاص عادوا فاعتقلوا وعذّبوا أو قتلوا واختفوا”.
لم يكن اللقاء مع الباحثين في مدينة أمستردام على بعد ساعة واحدة من المحكمة الجنائية الدولية، هيّناً. أنصار وأور فتحا تلك الحفرة قبل أيام، إلا أنهما لا يزالان عالقين في قعرها. ليس بديهياً الخروج منها بعدما أمضيا فيها أكثر من سنتين يحصيان عدد الضحايا، ويحاولان اقتفاء هوياتهم وهوية من قتلهم. جرت العادة أن يخفي المجرم وجهه أثناء الفظائع التي يرتكبها بضحاياه، إلا أن أمجد يوسف، في الفيديو المسرّب، لم يخفِ ملامحه، بل أخفى ملامح ضحاياه. عصب أعينهم فلم يشاهدوا موتهم، بل سمعوه.
وأنصار لم تكتفِ بالتسلل إلى تلك الحفرة المظلمة، ولم تكن مجرّد متفرّجة توثّق أعداد الضحايا، وتحصي أنفاسهم اللاهثة على حافة الموت. استعارت جسداً آخر وسمّته “آنّا”، وراحت تتجوّل وراء جلده بين تلك المجموعات التي قتلت، وتفنّنت في القتل وعذّبت واغتالت وامتهنت العنف.
ظلّت تتجوّل بينهم حتى عثرت عليه، صاحب قبعة الصيد، والندبة التي تحفر وجهه. إلا أنه كان قد اكتسب وزناً بعضلاته المفتولة، وترهّلت وجنتاه بعد ثماني سنوات على ارتكابه تلك الجريمة.
لن تكتفي أنصار السورية وصاحبة القضية أولاً، والباحثة ثانياً بالعثور عليه، بل ستوقع به كما أوقعت بغيره من مرتكبي “جرائم الحرب”، أو المشاركين فيها، أو الشاهدين عليها. كانت تحتاج إلى اعتراف مباشر بارتكاب القتل وممارسة العنف.
لولا “الأنسنة” لَما تحدثت إليه
عن اللقاء به، والخوض في حياته اليومية، والنظر إلى عينيه عبر شاشة الكومبيوتر والإصغاء إلى أحاديثه على مدار الأشهر، تقول أنصار، في لقائها مع “العربي الجديد”: “لم أكن أنظر إليه إلا كإنسان. لو كنت مكانه وعشت الظروف التي عاشها، لتحوّلت ربما إلى ما هو أشرس. لولا هذه “الأنسنة” لَما تمكنت من التعرّف إليه والحديث معه”.
وتضيف: “الأنسنة تختلف تماماً عن التعاطف. في لحظات كثيرة، كنت أتعاطف مع بعض من ألتقي بهم عبر العالم الافتراضي. أشخاص موالون للنظام، لكنّهم لم يتورّطوا في الدم السوري. أمجد متورّط. أمجد ابن المؤسسة ويصعب التعاطف معه. لديه هوية أعلى من تلك الهويات الطائفية الفرعية. الهوية العسكرية هي الأعلى والأقوى”.
وتتابع: “خضنا أور وأنا نقاشات كثيرة مع أصدقاء يعملون في الشأن ذاته، في محاولة لفهم هذه الشخصيات وفكفكتها. التدريب العسكري، وما يتعرّضون له من إهانات يومية، يصنع منهم أشخاصاً قساة، ويصبح العنف مجرّد ممارسة وظيفية، كالكتابة والتمثيل والطب. وأمجد بهذا المعنى ليس ضحية، بل صناعة وإنتاج مؤسسة عسكرية ترتكب الإجرام”.
أمجد صنيعة محيطه
يحكي أور عن منهجية البحث الاستقصائي الذي أعدّاه، وعن المخاطر الكثيرة المرافقة له. بعض زملائه في الجامعة يركّزون في أبحاثهم وعملهم مثلاً على العلاقة مع “المرتكبين” و”الجناة”، وعلى خطر التعاطف معهم، ما يحيل إلى تبرير تلك الجرائم والسلوكيات: “والد أمجد ضابط مخابرات، فما هي فرصته لأن يكون مختلفاً؟ والدي مثلاً مدرّس في الثانوية العامة، وأنا صرت مدرّساً في الجامعة. أمجد صنيعة محيطه، وإن كان ذلك لا يخفف من فداحة جرائمه، إلا أنه يشرح لنا ما يمكن أن تصنعه البيئة المحيطة المشجّعة على الإجرام وعلى ممارسة العنف”.
يكتسب عملهما أهمية إضافية لانطلاقه من البحث الأكاديمي. فمعظم الدراسات والأبحاث المتعلّقة بسورية، أو بأي رقعة حرب أخرى، تنطلق من ردّة فعلها على جريمة بعينها، بينما جاء فيديو “مجزرة التضامن” ليدعم ما كانا قد بدآ به قبل سنوات: البحث في جذور العنف وآلياته استناداً لعملهما في قسم الهولوكوست والإبادة الجماعية.
ترى أنصار أن “الخوف الوجودي يحيل إلى العنف. السلطة السياسية قالت منذ اليوم الأول إن الشخص الآخر، المضادّ، هو تهديد، وإن لم تقضوا عليه، قضى عليكم. الخوف عامل أساسي. حتى التظاهرات السلمية صارت تهديداً لوجود الآخر. النظام جرّهم إلى العنف، قال لهم إن لم تحملوا السلاح لن تعيشوا، لأنني لن أستطيع حمايتكم”.
يحكي أور عن الخوف بطريقة مختلفة، فهو لم يعشه، لكنه كان شاهداً عليه في أعين الهاربين من الحروب والقمع، والبلدان التي تحكمها المخابرات، ممن التقى بهم خلال السنوات الماضية.
يرى أور أن “الخوف بات جزءاً من الهوية السورية. ثمة عائلات، خرجت بأكملها من سورية، لم تعد لديها صلات مع الداخل، ومع ذلك، يُثقلها الخوف في أوروبا. الخوف يشلّ القدرة على التغيير وعلى القيام بعمل سياسي منظّم مرافق للثورة”.
ويقول إن “الفرق محزن بين طلابي الهولنديين في الجامعة وطلابي السوريين. طلبت منهم مرة أن يرفعوا أيديهم إن كانوا ضدّ الملك. معظم من رفعوا أيديهم كانوا من الطلاب الهولنديين، لأنهم يريدون نظاماً جمهورياً، بينما يخاف الطلاب السوريون من هذه الـ”ضد”، التي تودي بصاحبها في بلد كسورية إلى المجهول. الخوف يشلّ القدرة على الرفض وأيضاً على التفكير. إنه طبقة جلد ثانية بالنسبة للسوريين”.
أنصار التي عاشت خوفاً كبيراً خلال تواجدها في سورية وبعد خروجها منها، اختارت للمرة الأولى أن تظهر إلى العلن عبر التوقيع باسمها الحقيقي على الدراسة المنشورة في الصحافة العربية والأجنبية وفي تقرير صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، لأنها ضجرت من الخوف.
وتقول: “إن انتهى الخوف، ينتهِ النظام”. إلا أن خزّان الخوف في الذاكرة الجمعية السورية لا ينضب كما جرائم النظام. والخوف، الذي يبدأ محسوساً وواضح المعالم من الآخر الذي يشكّل خطراً على البقاء، يتحوّل مع مرور السنوات إلى خوف مبهم من أي آخر، وإلى عجز عن الخوض في المسائل الأساسية، خشية الوقوع في الخطأ وفي المساءلة والمحاسبة والتنميط وثم التخوين.
كما عبّر عنه أور، يتراكم الخوف طبقة بعد الأخرى، ويكتسب سماكة تجعله غير محسوس. هذا ما جعل ردود الفعل حول الدراسة متباينة جداً بحسب الباحثين، فهما طرحا للنقاش مواضيع ما زالت تنتمي إلى “المحرّمات”، ولم يبدأ السوريون الخوض بها بعد.
يقول أور إن ردود الفعل حول الفيديو المسرّب، والتقرير الذي نشراه، والتي عبّر عنها كثيرون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، جاءت سطحية في كثير من الأحيان وخاطئة.
ويضيف: “صحيح أن ما نشرناه يحيل إلى مسائل كثيرة، كالطائفية وغيرها، إلا أننا قررنا التركيز على أمور معينة بشكل عميق، كدور الطائفية وتعريفها في سورية. التغريدات والتعليقات التي جاءت حول عملنا، كانت في كثير من الأحيان سطحية ومغلوطة. وعندما قلنا إننا لم نعثر على خطاب طائفي في 27 فيديو شاهدناها عن مجازر وعمليات إبادة جماعية، فهذا حقيقي”.
لم ينس السوريون بعد أوجاع السنوات العشر الماضية، إلا أن الرداءة التي وصلت إليها حالتهم، وقتامة حياتهم اليومية، أغلقتا الحفرة إلى حين، وأقفلتا أعينهم على مشاهد العنف والقتل، وحلّت أحاديث الجوع والبرد وفقدان الحاجات الأساسية محلّ تمثيل النظام بالجسد السوري. الفيديو المسرّب والبحث المرافق له، وهذا الجهد الجماعي الذي قام به أشخاص تحرّروا من مخاوفهم بعض الشيء، أعادت فتح الحفرة، وذكّرت برائحة الموت والعنف، وبالسؤال عن الكراهية أيضاً.
أعاد طرح الفرضية حول قدرة ملايين السوريين على العيش المشترك، وعلى تجاوز خزّان الخوف والتحايل على ذاكرة السنوات العشر الماضية.
الحقيقة أهم من المحاسبة
تقول أنصار إن “الحقيقة أهم من المحاسبة. وإن السوريين قادرون على العيش معاً مجدداً، لكنهم بحاجة ماسّة للتعامل مع الماضي دون إقصاء الآخر ودون تجاهل سرديّته. عليهم الاعتراف بالخطأ. لن نستطيع العيش معاً إن لم نتصارح بما اقترفناه”.
ترى أنصار أن الحديث عن الماضي دون حقد أو نقمة، أو محاولة لتهميش الآخر المختلف عنّا، من شأنه أن يهزم الجهاز الأمني الذي يخاف من الحقيقة. وتقول إن “المشكلة أن مفهوم الضحية، الذي يمكن تعميمه على الأكثرية في الحالة السورية، يُقدَّم بطريقة انتقامية وليست حقوقية. الضحية تمتلك حقوقاً، وليس الانتقام هو السبيل لنيلها”.
إلا أن السوريين كما تعتقد أنصار لا يمتلكون أرضية مشتركة. ثمة نبذ مناطقي برأيها، والكلّ يدفع ثمن أفعال البعض. وتقول: “مجرّد أن تكون من حي الزهراء الموالي للنظام في حمص على سبيل المثال فأنت مجرم. وابن حي السبيل سيقاتل ابن حي الزهراء من دون أن يعرفه، والعكس صحيح. المشكلة أنهم تقاتلوا وقاتلوا بعضهم، قَتلوا وقُتلوا وكرهوا دون أن يعرفوا عن بعضهم شيئاً”.
وحتى إن كانت انتهاكات النظام لا تقارن بتجاوزات المعارضة، إلا أن هذه الأخيرة أخطأت، بحسب أنصار، في اقتحامها المسلّح لحي التضامن وإقدامها على الخطف، ما دفع إلى مزيد من العنف. خاصة وأن حي التضامن يضمّ أشخاصاً لم يتورّطوا في الدم السوري.
وتعتبر أنصار أن التسليح ردّ فعل طبيعي للدفاع عن النفس، إلا أن دخول مجموعات مسلّحة إلى مناطق مختلطة، كحي التضامن، هو قرار سياسي. وتقول: “عنف ضئيل من جانب المعارضة كان كفيلاً بإشعال مخاوف الآخر، وبالتالي إشعال جرعة أكبر من العنف”.
تبدو الأحاديث عن النزعة الإقصائية، أو عن الرغبة بالانتقام، ترفاً أو تنظيراً في ظلّ افتقار السوريين وعائلات الضحايا بشكل أساسي للعدالة والمحاسبة.
يرى أور أن النقمة ستلعب دوراً كبيراً في سورية، كما أن ثقافة المنطقة العربية لا تساعد على تحييد هذا الدور، لأنها ثقافة غير متسامحة عموماً، وتعتمد مبدأ العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. ويقول إن “لم يخرج من سورية شخص كنيلسون مانديلا ستشهد تلك المدن التي فتك النظام بأهلها انتقاماً مريراً. غياب العدالة يولّد النقمة والحاجة للانتقام”. والانتقام بمعناه المجازي الذي لا يخلو من المبالغة، يتحوّل إلى واقع.
ويضيف أور: “أمجد انتقم لأخيه، لكنه قتل في المقابل أكثر من 300 شخص! هنا خطورة الأمر. أن يتحول التعبير المجازي عن الرغبة بردّ الصاع صاعين إلى حقيقة. وهذا ما شهدناه في حالة أمجد، وفي حالة أشخاص كثيرين غيره. فعله الانتقامي ينتمي إلى الفانتازيا”.
أمجد يختصر اليوم كل الإجرام الذي شهده العديد من المناطق السورية منذ انطلاق الثورة قبل 11 سنة. كما يختصر الظلم الذي يعيشه أهالي الضحايا.
برغم فداحة ما ارتكبه (وما شاهدناه هو بعض تلك الجرائم فقط) إلا أنه لا يزال حرّاً طليقاً، يتجوّل في أحياء دمشق، بينما الملايين من السوريين لاجئون أو مهجّرون أو مغيّبون. وكيف لنا أن نحلم بأن تغيّر تلك المشاهد المرعبة المعادلة، وأن تُسقط نظاماً فاق إجرامه الخيال، ونحن لم نشهد بعد ولا ومضة عدالة واحدة، باستثناء الجهود الجبّارة التي بذلها حقوقيون سوريون في ألمانيا، وأدّت إلى بعض المحاكمات.
وبالعودة إلى الرغبة بالانتقام وعلاقتها بغياب العدالة، تقول أنصار إن من حقّ السوريين أن يكرهوا، شرط ألا تؤدي تلك الكراهية إلى العنف.
وتوضح: “ثمة ما يقارب 5 ملايين سوري تورّطوا في العنف برأيي. بدءاً من الذي اقتاد الناس إلى السجون، وصولاً إلى الذي قدّم لهم الطعام، أو سلبهم حقّهم في تناول الطعام، مروراً بمن شارك في حفر تلك الحفرة، أو ذلك الذي أبلغ عن جاره. ماذا نفعل أمام هذا الرقم المرعب؟ هل نقصي 5 ملايين سوري متورّطين بشكل أو بآخر بالعنف، أم نبحث عن آلية عدالة تناسب الحالة السورية، بحيث تُحفظ الذاكرة دون أن تعالج بالعنف؟”.
المعضلة تكمن في أن حجم التضحيات التي قدّمتها الأكثرية السورية، وحجم الخسائر البشرية والعاطفية والمادية يُفقدان هذه السردية أهميتها التاريخية المستقاة من تجارب شعوب أخرى تعرّضت للإبادة الجماعية أو للمجازر والعنف الممنهج. إذ كيف يمكن لمن سرقت منه البراميل الموجّهة على مناطق بعينها أعزّ من يملك أن يقبل بالسردية القائلة إن النظام ليس طائفياً، وإن أمجد لم يقتل بدافع طائفي، بل بدافع انتقامي ضدّ كل من يخالفه الرأي بغض النظر عن انتمائه الضيّق.
يقول أور في الإجابة عن السؤال حول العلاقة بين السردية والتجارب البشرية: “العنف يكتب تاريخ المجتمعات ويقسّمها إلى شرائح. في البوسنة مثلاً، أغلبية الناس اعتبروا أنفسهم بوسنيين، لكن عندما أتى المتطرفون القوميون من صربيا قتلوا الناس عرقياً فأعادوا تقسيمهم”.
ويضيف: “العنف يؤدي إلى تلك التقسيمات الجديدة. كثيرون اعتبروا سابقاً أنهم سوريون قبل كل شيء. إلا أن العنف الذي بدأ على أساس طائفي، ساهم في تلك التقسيمات الطائفية وأنشأها. ثمة فرق بين الطائفية والتقسيم. العنف يؤدي إلى التقسيم وليس العكس”.
ويوضح أنه “في الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في العام 1994 مثلاً، أجبر المتطرّفون من الهوتو باقي الروانديين على أن يتخلّوا عن انتمائهم الأوسع، ويختاروا في لحظة مصيرية انتماءهم الضيّق أو يفقدوا حياتهم. ليست الهوية هي التي تنتج العنف. بل العنف هو الذي ينتج تلك الهويات المتعددة والمتناحرة”.
ترى أنصار أن النظام استطاع أن يخترق بمؤسّسته العسكرية كل مفاصل المجتمع والدولة السورية، فجيّش المجتمع وعسكر الحياة. وتقول: “هو الذي أسّس للطائفية في سورية واستخدمها أداة سياسية يستبدّ بها عند كل أزمة. (الشعب السوري واحد) ليس سوى شعار. الشعب السوري لم يكن قادراً ولا مرة على الانتماء لهوية واحدة، هوية المواطنة. لم يكن قادراً لأن النظام سلبه هذه اللحظة”.
ومع أن الشعب السوري ليس واحداً من وجهة نظر أنصار، إلا أن الطرفين باتا مدركين أن النظام هو الذي أوصلهما إلى هذه الحالة العدمية وإلى هذا الحدّ من العنف.
وتقول: “كلا الطرفين خسر، كل الطوائف والمذاهب من مجرمي الحرب إلى ضحاياهم. الكلّ خسر معركته بسبب النظام، والكلّ ضحية للنظام”. وكما ساهمت سياسة النظام الإقصائية عبر عقود في تضييق الخيارات أمام السوريين وفي إلغاء أي أفق للتغيير، ساهمت إقصائية بعض القوى المعارضة في انسحاب شرائح كثيرة من صفوف المعارضة لتعود إلى كنف النظام.
وتضيف أنصار: “لم يكن عنف النظام هو السبب الوحيد لهجرة الكثيرين، أو لالتحاقهم في جبهات قتاله. بل إن رفض ممارسات بعض القوى السياسية المعارضة بطرق تذكّر بالنظام هو السبب وراء هروبهم. المعارضة لديها سجون، وتؤسس لنفس الحالة التي أسّس لها النظام السوري”.
إعادة اعتبار للضحايا
“أن نحكي قصة المجزرة الموثّقة هو إعادة اعتبار للضحايا واعتراف بهم وبكينونتهم وبتضحياتهم. الحفرة كادت تصبح من الأساطير. يروي أهالي الحي والأحياء المجاورة شكوكهم حول وجود حفرة، تراودهم الكوابيس من فكرة وجودها، يعانون في منطقة تابعة للنظام تماماً، لكنهم ليسوا متأكدين. من حقّهم أن يعرفوا هوية المجرم” تقول أنصار.
عندما وصلته تلك المقاطع المسجّلة من مجزرة حي التضامن، لم يفكّر أور سوى بالعمل عليها كمقاطع مصوّرة. إلا أن أنصار رأت سياقاً أوسع لهذه الفيديوهات التي تعبّر بشكل أو بآخر عن عملية التطهير الجارية في سورية، إضافة إلى التهجير والاغتصاب ومصادرة الممتلكات الخاصة العامة.
يقول أور: “ارتأت أنصار أن نضع هذه الفيديوهات في السياق الصحيح والأوسع لما يجري في سورية. لأن ثمة فرقاً بين المجزرة والإبادة الجماعية. فالمجزرة هي لحظة ارتكاب فعل القتل، أي اللحظة التي أردى فيها أمجد 41 مدنياً في الفيديو الذي انتشر قبل أيام، خلال فترة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة”.
ويضيف: “نعم هذه مجزرة. بينما الإبادة الجماعية هي سياسة المجازر في فترة زمنية ممتدة يسعى النظام من خلالها إلى تدمير المجتمع وتفتيته. ثمة فرق بين المجزرة كلحظة، وبين الإبادة الجماعية كفترة، والهدف هو “التطهير”. حتى أن النظام نفسه استخدم هذه المفردة في الكثير من المناسبات. والنظام السوري ارتكب الجريمتين معاً، المجازر والإبادة. التطهير والتدمير”.
ماتت “آنّا” وسُلّمت الفيديوهات كلّها للشرطة الهولندية والألمانية عسى أن تخطو في طريق العدالة والمحاسبة. أنهى أور وأنصار مهمّتهما في الوصول إلى مرتكب المجزرة أولاً، وفي البحث في خبايا هذا “الصندوق المغلق” كما يسمّيه أور الملقّب بـ”أبو خليل”.
إلا أن الإنجاز الأكبر بالنسبة إلى أنصار إلى جانب الكشف عن مجزرة موثّقة وعن هوية مرتكبيها، هو النقاش الذي فتحته في الداخل، وحالة الرفض والاستنكار التي وصلتهما بعدما شهدها العديد من العائلات الأقرب إلى النظام منها إلى المعارضة.
——————————-

أسرة الفلسطيني وسيم صيام تتعرف عليه من فيديوهات مجزرة التضامن
أحمد الهواس
سلط فيديو مجزرة التضامن الذي بثته صحيفة الغارديان البريطانية قبل أسبوع الضوء على مجازر جرت بحق الشعب السوري على يد النظام ولجانه الشعبية المعروفة بالشبيحة.
وأظهر الفيديو إعدام 41 مدنيا أعزل بدم بارد ورميهم في حفرة ثم حرقهم قبل ردم الحفرة، وما رافق ذلك من ألفاظ وكلمات طائفية وعنصرية، وهو واحد من 27 فيديو يوثق مقتل نحو 280 ضحية في هذا المكان بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2013 في شارع نسرين في حي التضامن جنوب دمشق.
المجزرة التي شاهد العالم تفاصيلها أدت لمعرفة بعض الضحايا من قبل ذويهم ممن تم قتلهم ودفنهم، وقد حسب مرتكبو هذه الجريمة أنها دفنت إلى الأبد، ومن هؤلاء أسرة وسيم عمر صيام، التي تقطن في مدينة فرانكفورت منذ 2016، وهي أسرة وصل أفرادها لألمانيا على مراحل في رحلة شاقة ومؤلمة.
كيف تم التعرف على وسيم؟
والد وسيم، عمر صيام فلسطيني مواليد 1954 من مخيم اليرموك خريج جامعة دمشق لغة عربية، قال للجزيرة نت “لن أتحدث عن كوني أبا مفجوعا بابنه البكر، ولكن بلسان كل أب فقد ابنه على يد النظام وشبيحته وكل أسرة فقدت أبناء لها ولا أحد يعرف عنهم شيئا وكأن دماء الأبرياء لا قيمة لها”.
وعن تعرفه على ولده، قال “شاهدت والدته الفيديو المسرب كما شاهده الملايين، فعرفت وسيم، كانت صدمة كبيرة لا شك في ذلك، كان هناك يقين لدي أن ابني قد تمت تصفيته على يد النظام ولكن لم يخطر ببالي قط أن تكون بتلك الطريقة”.
وأضاف “وسيم خرج للعمل ودخل لمنطقة التضامن في 14 أبريل/نيسان 2013 بحثا عن طحين ولم يعد، وهو كما يعرفه الجميع خلوق ومهذب وليس له أعداء، وقته مكرس للعمل وأسرته، فهو خريج معهد متوسط فندقي وعمل بالشيراتون والميرديان، متزوج وعنده طفلتان سيدرة ورونق، كانتا تبلغان من العمر وقت اختفائه 6 و4 سنوات”.
ويتابع “بحثنا عنه ولم نصل لنتيجة وتم ابتزازنا من قبل بعض ضباط النظام، حيث دفعنا في وقتها لأحد السماسرة واسمه مصطفى زين القلعاوي ما يعادل 6 آلاف دولار أخذها من والدي رحمه الله الذي توفي 5 سبتمبر/أيلول 2013، مقابل الكشف عن مصير وسيم، وبعد سنة من اختفائه سافرت لجبلة لأحد أقارب سهيل الحسن (عميد في جيش النظام السوري) وكان الاتفاق أن أعطيه نحو 10 آلاف دولار مقابل الإفراج عن ابني -حيث كنا نظن أنه معتقل- فأخبرني ألا أبحث عنه فليس له أي قيود في الاعتقال وهو يرجح تصفيته على أحد حواجز اللجان الشعبية”.
الرحلة إلى ألمانيا
يصف والد وسيم حياة الأسرة أنها باتت جحيما لا يطاق بسبب التضييق على مخيم اليرموك منذ بدء الثورة السورية، حيث اضطر لإرسال ابنه خالد قبل حادثة ابنه وسيم بقليل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، بسبب البحث عنه من قبل النظام بذريعة سوقه للتجنيد الإجباري.
ويتابع “بعد اختفاء وسيم اضطررت لإرسال ابنتي أريج ومعها سيدرة ابنة وسيم في 2014، لكن السلطات اليونانية احتجزت الطفلة لمعرفة أهلها، وهنا أرسلت زوجة وسيم ومعها طفلتها رونق، والحمد لله أخذت ابنتها من اليونان بمساعدة الكريتاز الألماني (منظمة إغاثية) واستقروا جميعا في ألمانيا، وفي 2016 قررت الهجرة ووصلت ألمانيا بهجرة غير رسمية عن طريق تركيا”.
عرفته من بنطاله
والدة وسيم السيدة سهام أبو صيام، قالت للجزيرة نت “كنت أتابع الجزيرة التي نشرت تحقيق الغارديان عن مجزرة التضامن، وكنت أظن أن الأمر يتعلق بمجزرة حديثة، قبل أن أنتبه لتاريخ 16 أبريل/نيسان 2013 وأربط بينه وبين تاريخ فقدان ولدي، انتابني شعور غريب ونظرت إلى شاب يساق إلى الموت فصرخت هذا وسيم أنا أعرف اعتزازه بنفسه فهو يقف بشموخ”.
وتابعت وقد اغرورقت عيناها بالدمع “كانت الملامح غير واضحة بسبب الضرب على الوجه، ولكني أعرفه من ذقنه والبنطال الجينز الذي يرتديه، لقد غسلته بيدي قبل يوم، وقد ارتداه في بيتنا في السادسة صباحا فقد نام في بيتنا تلك الليلة، وهذه ملابس عمله، وكان ينتعل حذاء رياضيا، وخرج لحي التضامن لأجل شراء طحين، وقتها طلبت منه ألا يذهب وهناك خطر، قال لي العمر واحد وطلب الدعاء، ما أطالب به العدالة لابني ولسواه والقصاص من المجرمين”.
وختمت حديثها “هؤلاء ليسوا بشرا ومن المعيب أن يبقوا أحرارا دون محاسبة، الجريمة طائفية وعنصرية بامتياز”.
غالبية الضحايا من شباب مخيم اليرموك
خالد شقيق وسيم قال إنه كان دائما ينشر عن شقيقه على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أخبره أحد الأصدقاء بأن أخاه من ضمن الضحايا، كما قال للجزيرة نت.
وأستدرك “لكن أود أن أقول لكم أمرا ربما لم يتم التطرق إليه في وسائل الإعلام، الجريمة التي حصلت وهناك ربما عشرات لم يعلن عنها، كانت تتم بدوافع طائفية وعنصرية، فجل الضحايا من الفلسطينيين، فالمكان الذي وقعت فيه المجزرة بشارع نسرين حي التضامن يقطنه ضباط وعناصر من الطائفة العلوية، وهم الكثرة هناك، وقلة من الطائفة الدرزية، وهذا المكان كان تحت سيطرة الشبيحة، وقد سبق لهم ارتكاب مجزرة مروعة بحق أبناء شارع الجاعونة في مخيم اليرموك وذلك في الثاني من أغسطس/آب 2018، حيث قصفوا الشارع بقذيفة هاون، وحين تأكدوا من تجمع الناس لإنقاذ المصابين قصفوا التجمع بقذيفة أخرى مما أدى لسقوط 15 شهيدا وعدد كبير من الجرحى”.
وختم خالد حديثه “وما مجزرة التضامن إلا تعبير عن البعد الطائفي ضد الضحايا وزاد في الحقد أنهم فلسطينيون”.
اعتصام في برلين ولاهاي
الناشطة ميسون بيرقدار، قالت للجزيرة نت التي التقتها في منزل أسرة وسيم إن “ما وقع من جرائم بحق الشعب السوري كفيلة بتحرك قوي من المجتمع الدولي تجاه النظام، فخلال 11 عاما فقد الشعب السوري نحو مليون قتيل وهناك عشرات الآلاف من المغيبين قسرا، وقد لعب الإعلام دورا كبيرا في تسليط الضوء على هذه الجرائم كما فعلت قناة الجزيرة في فيلم حفار القبور”. وتابعت “ما يظهر للإعلام هناك أضعافه ولا أحد يعرف عنه شيئا”.
أما عن دور الناشطين السوريين في مجال حقوق الإنسان، فقالت ميسون “تواصلت مع أسرة وسيم وحضرت من برلين لكي نقول لهم نحن معكم ونعيش آلامكم، وقررنا كناشطين الاعتصام لمدة أسبوع في برلين ابتداء من يوم السبت المقبل أمام السفارة الروسية، وبعد ذلك في لاهاي للفت النظر إلى المجازر التي حصلت في سوريا بمساندة حلفاء النظام، ولن نتوقف حتى تأخذ العدالة مجراها”.
المصدر : الجزيرة
——————————
مجزرة التضامن فضيحة جديدة للاستبداد الأسدي…
تم الكشف في الأسبوع المنصرم عن ما تم تسميته مجزرة حي التضامن التي يعود تاريخها إلى 16 نيسان من عام 2013، وقد أثار نشر المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع من قبل صحيفة الغارديان البريطانية، الكثير من النقاشات المكررة في أوساط السوريين، النقاشات التي تعبر عن تعقيدات الوضع السورية التي سرعان ما تطفو على السطح بسبب حدث ما.و قد كان لافتاً صدور مرسوم جديد للعفو عن الجرائم الإرهابية بعد ثلاثة أيام من نشر قصة مجزرة التضامن دون وجود ارتباط أكيد بين الحدثين.
وقد يعود جزء من الإثارة أو الاهتمام الزائد في التعامل مع الحدث، هذه المرة، إلى الطريقة الخاصة التي تم بها الكشف عن المجزرة، كونها كانت نتاج متابعة باحثَين من مركز الهولوكوست والإبادة في جامعة أمستردام الهولندية، أحدهما كردي- تركي والأخرى سورية بعد عمل لمدة ثلاث سنوات. وفي حين أن تاريخ الثورة شهد الكثير من المجازر والتي كان ضحاياها ربما أكبر عدداً، لكننا هنا أمام حالة جديدة تتميز بتحديد واضح للمجرم و بعض مساعديه، وربما الأهم من ذلك تحديد الفرع الأمني الذي ينتمي إليه، والأكثر أهمية هو تواصل أحد الباحثَين بشكل مباشر مع المجرم والحصول على معلومات مباشرة منه، أي أننا هنا لسنا أمام معلومات تقدمها معارضة ما عن نظام وتحمل بالتالي شبهة الانحياز والترويج الإعلامي.
رغم أن عناصر جريمة الحرب متوفرة حيث الضحايا، كما في أغلب المجازر، مدنيون وبينهم نساء وأطفال، ورغم سعي بعض الجهات الحقوقية إلى توصيل المعلومات إلى المدعين العامين في ثلاثة دول تقر بالولاية القضائية العالمية هي ألمانيا وفرنسا وهولندا، فإن النتائج المترتبة على ذلك ستكون على الأغلب محدودة بسبب المناخ الدولي السائد، وأيضاً لأن النظام السوري لا يمكن أن يسلم المجرمين لأي محكمة دولية. لكن بالمقابل هناك أهمية سياسية لمتابعة الموضوع بسبب التحديد الواضح للأشخاص المتورطين وللجهة الأمنية التي يتبعون لها.
وقد شهدت القضية عدة مقاربات أو مقارنات غير موفقة برأينا منها مثلاً التذكير بجرائم داعش أو الفصائل الأخرى، وهي جرائم تستحق بدورها الملاحقة والإحالة على محاكم عادلة، حتى لو كان ضحاياها أقل عدداً من ضحايا مجازر النظام، لكن الخطورة في الجرائم التي يرتكبها النظام، بواسطة أدواته المتنوعة، كونها صادرة عن نظام سياسي معترف به عالمياً، وليس عن ميليشيات لا تمثل كياناً حقوقياً شرعياً، وبعضها مصنف على أنه إرهابي.
ولأن معظم المجرمين من طائفة محددة والضحايا من طائفة أخرى فمن جديد تطل أيضاً القضية الطائفية كمرجع في نقاشات السوريين عبر وسائل التواصل، إن الإقرار باعتبار الطائفية أحد المرتكزات التي تؤمن للنظام عصبية هامة لتماسكه لا يجب أن يدفع لاعتبار الطائفة العلوية كتلة صلبة وراء النظام وتحميلها مسؤولية المجازر، لأنها ليست كذلك فعلاً، وليس فقط لوجود عناصر من الطوائف الأخرى استخدمها النظام في عمليات القمع والإبادة الجماعية التي يقوم بها، إن تسعير الخطاب الطائفي، المرفوض أصلاً، واعتماده من جديد كأساس في مواجهة النظام لن يخدم أبداً السعي لاستعادة ولملمة سورية المبعثرة لتعود وطناً لكل السوريين على أساس مبدأ المواطنة المتساوية، وبالعكس فإن ترويج الخطاب الطائفي يخدم النظام من جهة وأصحاب المشاريع المتطرفة من جهة أخرى.
من خلال الفيديو المسرب تم حتى الآن التعرف على بعض الضحايا وهم من الفلسطينيين السوريين، ومن المعروف أن المجزرة جرت في حي “التضامن” في دمشق وهذا الحي ملاصق لمخيم اليرموك الفلسطيني، ورغم أن معظم القيادات الفلسطينية انحازت للنظام السوري منذ بدء الثورة السورية، فقد دفع الفلسطينيون من سكان المخيم ثمناً باهظاً في الصراع مع النظام، ومن المؤسف أن بعض السوريين لا يقدرون هذه الحقيقة قدرها، أو يستخدمون أحياناً بعض عبارات الشماتة أو التشفي غير المتناسبة مع عمق وخصوصية العلاقة السورية الفلسطينية تاريخياً.
أخيراً، ورغم أن هذه المجزرة لم تحظ بالاهتمام السياسي الكافي عالمياً، فلابد من الاستفادة من كل مجالات العمل السياسية والحقوقية لإبقاء النظام في موقع المعزول والمحاصر وغير القابل لإعادة التأهيل، ولتحقيق ذلك فإننا بحاجة أولاً إلى تبني الخطاب الذي يقر بسورية المستقبل دولة المواطنة الديموقراطية التي تقر بالحقوق الأساسية لمواطنيها كأفراد وبالحقوق الجماعية لمكوناتها القومية والثقافية، ثم علينا العمل من أجل إقامة جبهة ديموقراطية عريضة تناضل من أجل تحقيق الإنتقال السياسي في سورية.
2 ايار 2022
تيار مواطنة-نواة وطن
مكتب الاعلام
———————————
تقرير القناة الالمانية الاولى حول مجزرة التضامن (مترجم للعربية)
————————
العديد من جرائم ضباط نظام الأسد التي لم تجد من يصورها!
النقيب وائل الخطيب – الناس نيوز ::
سلسة أحداث واقعية يوثقها النقيب السوري المنشق وائل الخطيب ، في سلسلة تقارير تنشر تباعا على صفحات “الناس نيوز”
مطلع الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة “الغارديان” تحقيقاً يظهر قيام مجموعة من المسلحين تابعة لقوات النظام الأسدي ، في أبريل/نيسان 2013، بإعدام 41 مدنياً أعزل بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال، ثم رميهم في حفرة قبل إضرام النيران في جثثهم ، مشهد مأساوي ومؤلم جدا على الجميع حول العالم ، لكنه للأسف لم يحرك ساكناً لدى صناع القرار الإقليمي أو الدولي .
وأظهر المقطع المصور، طلب عناصر نظام بشار الأسد من عدد من المدنيين المعتقلين الركض، في حين كانت أيديهم مكبّلة خلف ظهورهم وأعينهم معصوبة، قبل أن يطلقوا النار عليهم ، ليسقطوا في حفرة مليئة باطارات السيارات ، كي يحرقونهم بعد ذلك .
كما أظهرت بعض الصور اقتياد مدنيين وإلقاءهم في حفرة وإطلاق النار عليهم، حيث تبين أيضاً تكديس العناصر المسلحة جثث المدنيين الضحايا فوق بعضها، وإلقاء إطارات سيارات وأخشاب فوقها بالإضافة إلى سكب مادة البنزين عليها ثم إحراقها.
ولعّل السؤال الذي يطرح في هذه الحالة هو، هل الجريمة الفظيعة ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام في التضامن هي الوحيدة في سجله الإجرامي، أم أن هناك فظائع أكبر لكن لم يكتب لها أن توثق أو ربما تم توثيقها لكن لم ترَ النور بعد؟
النقيب السوري وائل الخطيب تمكن من مقاطعة مصادر مختلفة مع المعلومات التي بحوزته، وتوصل لحقائق يعرضها على الرأي العام عبر جريدة “الناس نيوز” الأسترالية .
عشيّة اندلاع الانتفاضة الشعبية التي انطلقت شرارتها من درعا عام 2011، تلقى العميد إلياس ، ح ، أوامر من قادته بزج دبابات الوحدة العسكرية التي تأتمر بأمره ، زجها في الشوارع، وإقامة حواجز مدعومة بهذه الدبابات على الطرقات، وتفتيش المدنيين ( كل ما جاء ويأتي هنا من معلومات هي تعود لأرشيف ومعلومات النقيب الخطيب وعلى مسؤوليته وهو يؤكدها مجدداً ) .
وينحدر العميد إلياس من مدينة حمص السورية ، وكان قد أنيط به قيادة الكتيبة 143 دبابات التابع للواء 61 والمتمركزة قيادتها في قرية الشيخ سعد بمنطقة حوران جنوب سوريك عام 2011.
ونشر العميد ب وحداته المدججة عبر عدة حواجز وهي، حاجز على طريق نوى درعا في الشيخ سعد (يقوده المقدم كاسر ح – طرطوس).
وحاجز على طريق نوى تسيل ، بالقرب من تل الجموع يقوده النقيب رائد من جبلة، والملازم طلال من قرية نبل .
وحاجز في قرية سويسة يقوده الرائد باسل إ (طرطوس)، وحاجز في قرية عين ذكر يقوده الرائد فهد ع (اشتبرق).
وكل من ذكر كان ينفذ المهمة الموكلة إليه بفيض من الإجرام وأشبه ما يكون بـ ” بالذئاب المسعورة ” حيث يتعرض كل من يتم إيقافه من المدنيين على هذه الحواجز لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب والإهانة، ليتم تحويلهم لاحقاً إلى مركز قيادة الكتيبة مضرجين بالدماء ومكسوري الأضلع والأطراف.
وقصة التعذيب تبدأ فصلاً جديداً في قيادة الكتيبة، حيث توكل مهمة التعذيب لباقي الضباط العلويين ( استخدام أسم الطائفة هنا كان مطلبهم وتكريسها في الجيش كنوع من الرسالة انهم القوة الضاربة التي ستقمع الانتفاضة السنية وهو ما يتفق مع خطة النظام بأن السنة يستهدفون العلويين الخ ) ليتفننوا في ابتداع طرق تعذيب تصل لدرجة فقء الأعين وقطع الأعضاء الذكرية للمعتقلين، واغتصاب النساء بوحشية وأساليب قل نظيرها ويتركون الضحايا بعد ذلك ينزفون حتى الموت.
وكان العميد إلياس ( من الطوائف المسيحية ) والنقيب رائد س ينفذان عمليات الإعدام على حائط قاعة الترانجور (مقلد الرمي)، والذي شهد إعدام أكثر من ثلاثين شاباً سنياً حورانياً وعدة مجندين سنة بتهمة محاولة الانشقاق، ويتم دفن الجثث في المرابط التبادلية للدبابات (وهي عبارة عن حفر بعمق ثلاثة أمتار تستخدم كخنق للدبابة)، وتحولت تلك المرابط لمقابر جماعية.
ويؤكد صحة هذه المعلومات المدنيون من قرية الشيخ سعد، ويعرفون صحة كل الحقائق التي سقناها، وهم كما غيرهم لم يسلموا من بطش العميد إلياس وضباطه الطائفيين، حيث أحرقوا منازل الشيخ سعد وبعض المنازل تم إضرامها قبل مغادرة قاطنيها.
يشغل إلياس ب في الوقت الراهن رئاسة قسم البدل في إدارة السجلات العسكرية، ويتواصل مع بعض المنظمات المسيحية وبعض من يدعون المعارضة ليؤمن خروج عائلته لأوروبا بحجة تعرضهم لـ “الاضطهاد”.
——————————
========================

تداعيات “مجزرة التضامن” ومرسوم العفو عن المعتقلين في سورية
———————————–
سورية.. من المجزرة إلى مرسوم “العفو”/ عمار ديوب
أصيب السوريون بالذهول من بشاعة مجزرة حي التضامن. قتلٌ، ومن ثم حرقٌ للجثث. أيام قليلة وصدر مرسوم عفو رئاسي. ربط كثيرون بين المرسوم والحاجة إلى التغطية على المجزرة. فعلاً، بدأ أهالي المعتقلين بالنزول إلى قلب دمشق النابض بالعروبة، فمن تحت جسر الرئيس، إلى المرجة، إلى قصر العدل، إلى صيدنايا، إلى .. إلى .. الصور المنقولة من وسائل تابعة للنظام: يوميات قذيفة هاون، إذاعة شام إف إم، وغيرها، تقول إن أعداد الأهالي المتجمعين هنا وهناك فاقت الآلاف. ظن الناس أنّهم سيرون أولادهم أخيراً. وتوهموا أن النظام قد يعود إلى رشده، وأن أمهات سينمن وهن يحتضنّ فلذات أكبادهن. لم يحدُث شيء من هذا.
تفيد التقديرات الأولية بأنه جرى الإفراج عن أقل من مائتي معتقل. لا يقدّم النظام أيّة معلومات عن المعتقلين والمغيبين قسراً، ولم يُطلق سراحهم ضمن عملية سياسية تؤدّي إلى طي الحقبة السوداء في عهده منذ 2011. تنتظر عائلاتٌ أولادها منذ أكثر من عشر سنوات، أو أقل بقليل؛ آلامهم التي بثّوها عبر كل منصّة تواصل ممكنة تقول إن الألم المختزن في قلوبهم بحجم سورية كاملة. والمعتقلون ينتمون إلى كل جزء من الجسد السوري، بمناطقه وقومياته. لكن قلة عدد المعتقلين تنفي الربط بين المجزرة ومحاولات التغطية عليها. يُشاع أن النظام شكل هيئة من القضاة منذ فترة، سابقة على المجزرة، للإعداد لـ”العفو”، وربما يكون لذلك صلة بمحاولات إماراتية وجزائرية لشرعنة النظام، نصحته بإصدار بعض المراسيم، كان جديدها مرسوم “العفو” هذا. لكن بعض تلك المراسيم والقوانين أرادت أيضا إظهار “العين الحمراء” للشعب “الموالي” بأن النظام لن يتهاون مع أي انتقاداتِ على وسائل التواصل الاجتماعي؛ عليكم الانتباه جيداً، وإلّا.
يشكل موضوع المعتقلين قضية حساسة لدى شعوب العالم كافة، وما قرأناه وشاهدناه من مقاطع فيديو مسرّبة يجعلنا نتألم بشدة. لم يهتم النظام لأوجاع الأهالي، والأرقام تتحدّث عن أكثر من مائتي ألف معتقل ومغيّب قسرياً، وليس من معلومة واحدة أكيدة عن أماكنهم، وهناك سوق رائجة للسمسرة والنهب مقابل أي معلومة عن أهاليهم ولو كاذبة، فليس للقضاء سلطة فعلية في هذا الملف. والمعتقلون موزّعون بين سجن صيدنايا سيئ الصيت وأقبية الأجهزة الأمنية التي لا تعترف أصلاً بوجودهم، ويمنع الأهالي من مراجعة مكاتبها، والناس أصلاً تتجنّب الذهاب إلى هناك، ما دام الداخل إليها مفقودا، والخارج منها مولودا.
ظنّ السوريون أن الاعتقال طويل الأمد لن يتكرّر بعد الثورة. وفي الأشهر الأولى كان الإفراج بعد وقتٍ قصير عن المتظاهرين، ولكن لاحقاً، أصبح الاعتقال لأشهرٍ، ثم سنواتٍ، ولعقدٍ، وها نحن ننتظر مع الأهالي. اكتشفنا أننا غارقون في الأوهام؛ النظام هو هو، ولم تتغيّر طبيعته الأمنية والاستبدادية، منذ السبعينيات. يبدو تغيير ذلك مرتبطا بتغيير النظام ذاته، وهذا متعذّر. لم تستطع الثورة تغييره، ولم تُرد ذلك الدول المتدخلة بالشأن السوري، الداعمة للنظام والمعادية له على حد سواء.
كان الإفراج عن المعتقلين شرطا سابقا على أي مفاوضاتٍ مع النظام، لاحقا لم تهتم وفود المعارضة المفاوضة للنظام بآلام الأهالي والكوارث التي يعانيها المعتقلون، لصالح مفاوضات “تافهة” عبر اللجنة الدستورية، وفي أستانة، وسوتشي، وجميعها لم تفعل شيئاً بخصوص المعتقلين. مضت السنوات، ولم تحقّق جولات التفاوض إفراجا عن معتقلٍ واحد. وتأكد أن رفض التفاوض مع النظام يشكل موقفاً جادّاً من شأنه أن يفرض قضية المعتقلين على أجندات النظام وحلفائه والمجتمع الدولي. لم يتحقق هذا، والجولة الثامنة من اجتماع اللجنة الدستورية على الأبواب في 28 مايو/ أيار الجاري.
ليس مرسوم العفو الصادر أخيرا، شاملاً، وأية معارضة جادّة كانت ستفعل ما قلناه بكل بساطة؛ فالكلام يدور عن معتقلين سياسيين أو أفرادٍ مدنيين، لا ناقة لهم ولا جمل في العمليات المسلحة مثلاً، أو قاموا بعمليات إرهابية؛ هم بشر كان حظهم سيئا للغاية، إنهم ولدوا في سورية، وكانوا أحياء بعد عام 2011 واعتقلوا. أما دمشق التي عرّفت بأنها “قلب العروبة النابض” لاحتضانها مشروع التحرّر القومي، لم تعد منذ السبعينيات مدينة للأحرار، وتحولت، على يد الأجهزة الأمنية، إلى مدينة تحتضن أشهر المعتقلات العربية وأكثرها رعبا. حتى فلسطين أصبحت اسما لأحد الفروع الأمنية، ولا تزال السجون السورية عالما خفيا وسرّيا، لخصه المفكر السوري طيب تيزيني، حين وصف الدولة السورية بأنها “دولة أمنية”. وبالتالي لا تختزل المسألة في دور الأجهزة الأمنية، بل تتعلق بالدولة بأكملها مذ خضعت لتلك الأجهزة. كيف يمكن لدولةٍ كهذه أن تتصالح مع الشعب؟ كيف يمكنها أن تطلق سراح المعتقلين، وتطوي صفحة التغييب القسري والنظام الشمولي من دون ثورة ضدها، ومن دون ضغوط حقيقية عليها من الداخل أو الخارج. هذا ما لم تفهمه المعارضة، وقد صار لها شأن، بعد أن صارت محمولةً على ثورة، على عكس حالها قبل 2011.
يحق للأهالي احتلال قلب دمشق النابض بالمعتقلين، بحثا عن أولادها، فالناس تريد أن تتصالح مع الحياة، أن تنتهي من التفكير بالمصير الأسود لمن اعتقلوا. كل تجارب الاعتقال في سورية كارثية وجهنمية، ومن حق الناس أن تتعلق بأيّة قشة يظنون أنها قد تعيد لهم أولادهم. الآن، سيصاب الأهالي بالفاجعة من جديد، ولن يهتم النظام لأحوالهم مطلقاً، ولن يبادر إلى “تنظيف” المعتقلات، ولا إلى الإعلان عن مصير المفقودين، ولن يعتذر للشعب، ولن يطيح كبار ضباطه المسؤولين عن الأجهزة الأمنية التي تفنّنت في أشكال الاعتقال والتعذيب والقتل، ومجزرة التضامن ليست أولها ولا آخرها.
ألم استمرار احتجاز المعتقلين يفرض على المعارضة وكل المؤثرين في الشأن السوري رفض أيّ تفاوض مع النظام، قبل طيِّ صفحة الاعتقال والمعتقلين. لا ينبغي أن يكون هناك تنازل عن هذا الحقّ، فلا حلّ في سورية طالما بقي قلب دمشق ينبض بالمعتقلين ومعاناتهم، وخيبات أمال ذويهم، في مسلسلٍ مستمرٍّ من قتل ورعب.
العربي الجديد
————————–
صور من بيت الموتى السوريين/ بشير البكر
أراد النظام السوري أن يغطّي حفرة حي التضامن، ويحرف الاهتمام المركّز، محليا وخارجيا، على جريمة إعدام جماعي لـ41 مدنيا وإحراق جثثهم، بإصدار قرار عفو عام عمّا يسميها جرائم الإرهاب، والإفراج عن عشرات المعتقلين. واختار توقيت عيد الفطر كي يخلط الأوراق، وفي ظنّه أن فرحة بعضهم بعودة أولادهم من بيت الموتى سوف تطغى على أحزان وآلام المنكوبين من أهالي ضحايا مجزرة حي التضامن، الذين تعرّف عليهم بعض ذويهم من الصور التي تسرّبت، ومنهم الفلسطيني من أبناء مخيم اليرموك وسيم عمر صيام، الذي كان قد خرج لشراء أسطوانة غاز ولم يعد، ويبدو أن الحاجز القريب من منطقته استوقفه وساقه إلى هناك من دون تهمة محدّدة. ومثل هذا الرجل كثيرون اعتقلتهم أجهزة النظام، وصاروا في عداد المختفين قسريا، ومن بين هؤلاء سوريون وفلسطينيون، لم توثّق الهيئات المختصّة أسماءهم. وبالتالي، لا يعرف أحد عنهم شيئا، وتبيّن، من عملية الإفراجات الأخيرة، أن هناك سجناء مجهولون لجهة أسباب الاعتقال وظروفه، وبعض هؤلاء فقد الذاكرة في السجن.
الصور هي التي فضحت النظام، بينما أراد منها أن تغطّي على الحفرة، وكشفت أنها على اتساع المقبرة الجماعية السورية المفتوحة وعمقها ومداها. وخلال أيام العيد، تحولت صور الأهالي المنتظرين تحت الجسر من حالة انتظار الفرج والإفراج عن المعتقلين إلى عزاء جماعي، ولقاء للمكلومين الذين يترقبون منذ سنوات عودة أبناء، وأزواج، وأشقاء، وأقارب. تجمهروا بالآلاف تحت الجسر في حي الميدان وسط دمشق المعروف بجسر الرئيس، وصار اسمه لدى السوريين جسر الكلب. ومن بين اللقطات القاسية التي تداولتها وسائل التواصل رجل يعرض صورة شقيقه المعتقل على أحد المفرَج عنهم، مستفسرا عما إذا التقى صاحب الصورة في السجن أو شاهده، وكانت المفاجأة أنه هو الشخص المعني، ولكثرة ما لقيه من أهوال في السجن لم يتعرف عليه شقيقه، ولكن المفقود العائد من بيت الموتى تعرّف على صورته التي يعود عمرها إلى عشر سنوات، وهناك صور أخرى كثيرة وثقتها كاميرات الهواتف النقالة، وعرفت طريقها إلى وسائل التواصل، لتشكّل مجتمعة ألبوما للرعب في سجون آل الأسد. وكل واحدة منها رواية عما وراء القضبان، من تعذيب وتحطيم للسورين الذين حلموا بالحرية، ومرآة تعكس وجه هذا النظام الذي لم يترك أيا من أنواع الجريمة لم يرتكبه، وتجسّد قسماته وآثاره الموجودة في كل مكان. وأكثر ما تفصح عنه حالات وجوه الذين عادوا من سجون الأسد وتعابيرهم، وما تقوله صورهم وأشكالهم وردود أفعالهم، أنهم كانوا مدفونين تحت الأرض في مكان بعيدا جدا، ولكن أجسادهم لم تتحلل، لأن أرواحهم جديرة بالحياة والكرامة.
هناك 86792 مخفيا قسريا لدى النظام منذ مارس/ آذار 2011، بينهم 1738 طفلاً و4966 امرأة، موثقة أسماؤهم لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجرى رفع قضيتهم أكثر من مرة إلى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة، ونصّ قرار مجلس الأمن 2254 على ضرورة الإفراج عنهم من أجل تسهيل المفاوضات بين النظام والمعارضة، ولكن النظام لم يلتزم، بل إنه يفرج بين حين وآخر عن بعض الجثث، كما حصل في فبراير/ شباط الماضي عندما سلم أهالي 54 مفقودا من بلدة دير العصافير عبر السجل المدني إشعاراتٍ تقرّ بوفاتهم في السجون، ليرتفع عدد الذين اعترف بموتهم إلى 1056 منذ مطلع 2018. وهذا لا يعني أن هذا هو العدد النهائي للوفيات التي لم يعترف النظام بها كلها، وما وثقه قيصر وحده هو 6860 قتيلاً من بين 55 ألف صورة قام بتهريبها، لتشكل شهادة على جريمة إبادة لا مثيل منذ جرائم هتلر وستالين.
العربي الجديد
————————
أسباب خارجية وداخلية وراء صدور قانون العفو/ د.باسل معراوي
لا شكَّ أن المناورة واللعب على التناقضات بين الروس والإيرانيين في سورية يتقنها رأس النظام. وأضيف إليها مؤخراً إيهام بعض العرب أنه من الممكن أن يقفز من الحضن الإيراني أو يخفف ارتباطه به مقابل انفتاح عربي عليه يتجسد بإعادة شغله لمقعد سورية بالجامعة العربية وبدء إعادة تعويمه عربياً وبالتالي دولياً بل ذهب الظن أن معاهدة سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ممكنة… مع منافع اقتصادية تنتشل بقايا اقتصاد الحرب والفساد من غياهب الجُبّ التي أوصله إليه…
كانت بارقة الأمل تكاد تتحول لحقيقة عند الحديث عن خط الغاز العربي الواصل للبنان وضرورة رفع بعض عقوبات قانون “قيصر” والذي كان بعهد الرئيس بايدن يغط أساساً بنومة أهل الكهف… وازدادت الآمال بعد انفتاح دولة الإمارات العربية المتحدة عليه بزيارة وزير خارجيتها لدمشق ومن ثَمَّ استقبال رئيس النظام بأبوظبي إلا أن الرياح الدولية والإقليمية سارعت بعكس أشرعة النظام السوري وأمانيه.
أسباب خارجية
1- يعلم الجميع أن التدخل الروسي من بدايات الثورة سياسياً ولوجستياً ودبلوماسياً كان السبب الرئيسي في استمرار النظام بارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري حيث كانت السياسة الروسية فاعلاً منذ البداية حيث شاركت بصياغة بيان “جنيف 1” ومن ثَمّ التوسط بين النظام والإدارة الأمريكية لتسليم السلاح الكيماوي للنظام بعد مجزرة الغوطة ثم شارك الروس بصياغة القرار 2118. أما استعمال حق الفيتو فكان حكاية وحده وبالتالي عدم تمكن مجلس الأمن من توجيه إدانة أو تحويل ملف الجرائم المرتكبة للمحاكم الدولية… وعندما لم تفلح كل تلك الجهود مع جهود ميليشيا الحرس الثوري الإيراني متعددة الجنسيات.. تدخلت القوات العسكرية الروسية بشكل مباشر والتي قالوا مراراً إنه لولا فعل ذلك لسقطت دمشق خلال أسبوعين…
ما أريد قوله أن رمز نجاح التدخل العسكري الروسي بسورية هو بقاء بشار الأسد في الحكم.. لذلك كانت الجهود الروسية تصبّ في ذلك الاتجاه بمنحيين اثنين… أولهما تغيير المعادلة العسكرية على الأرض لصالح قوات النظام وثانيهما سياسي دبلوماسي بالعبث بالقرار الدولي 2254 وتعطيل أي مسار جدي للحل واجتراح مسارات تضليلية لتقزيم القضية كمسار أستانة ومسار اللجنة الدستورية إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه الآن…
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا واستحالة أي تعاون أمريكي روسي بأي ملف من الملفات ومن ضمنها الملف السوري… وبسبب فشل الحرب الروسية بالمرحلة السابقة وفقدها لزخمها وبالتالي إمكانية تحولها لحرب استنزاف طويلة عسكرياً واقتصادياً.. وتوقع فرض عزلة دولية شاملة على روسيا… فإن روسيا بالتأكيد سيضعف دورها الخارجي خاصة في سورية ويبدأ التآكل يعتري دورها في سورية بل وفقد اهتمامها به باستمرار أمد الحرب وتداعياتها.. فإن النظام بذلك سيخسر حليفاً عالمياً قوياً كان له الدور الأكبر ببقائه جاثماً فوق صدور الشعب السوري.. وبالتالي قد يكون قرار العفو الأخير في محاولة من النظام لبدء مواجهة مرحلة جديدة أن روسيا بعد 24 شباط ليست كما قبلها.. وما عليه إلا التخلي المجاني عن ورقة المعتقلين التي كابر كثيراً للإمساك بها.. لأنه لا ظهر دولي يستند إليه الآن
2- تعتبر المصالحات الجارية الآن في الإقليم بين قطر وبعض دول الخليج ومصر… وتركيا مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل..وقبلها توقيع الاتفاقات الإبراهيمية.. إن هذه المصالحات التي تمت بين دول كانت على عداء فيما بينها.. تمت كلها تحت تأثير وصول رئيس ديمقراطي لسُدّة البيت الأبيض ومجاهرته برغبته بالعودة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس ترامب.. والتغول الإيراني لميليشيا الحرس الثوري بـ4 عواصم عربية بالإضافة لغزة.. واستهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عبر أدواتها وإلحاق الأذى بها… إضافة لأسباب أخرى جعلت أن هذه الدول الشرق أوسطية المهددة بتطاير شرر الميليشيات الإيرانية تعمل على إنهاء خلافاتها.. تحت عنوان وإن لم يكن ظاهراً الآن لكنه معروف للجميع لمواجهة المشروع الإيراني.. وسوف تتوج تلك المصالحات والتطبيع الذي تلاها بين الدول المتخاصمة ضمن منصة أو منظمة تنسيق أو تعاون أمني وعسكري يملأ أي فراغ ينجم عن تخفيف التواجد أو الاهتمام الأمريكي بالمنطقة…
ما حصل من تطورات إقليمية لا يصب بمصلحة نظام الأسد (أحد أذرع المشروع الإيراني).. وبالتالي مواجهة الدول مجتمعة لإيران وأذرعها ستمنع عليه أي مناورة باتجاه هذه الدولة أو تلك.. وبالتالي سيكون النظام أضعف بالتأكيد بمواجهة جواره.
3- إن حدوث الانسداد بمحاولة التوصل لاتفاق نووي بين الولايات المتحدة وحلفائها مع إيران أصبح أمراً واقعاً بالمدى المنظور الآن.. وسيعقب ذلك عدم وصول أموال للنظام السوري وتحمل تبعات الحروب الرمادية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى والتي يدور القسم الأعظم منها فوق الأراضي السورية.. أو توجيه الميليشيات الإيرانية لرسائلها من الأرض السورية… كل ذلك سيجعل النظام أضعف من المرحلة السابقة بكثير.
أسباب داخلية
1- لا أظن لو أن الدور أو التأثير الروسي حاضر كما في السابق لما أصدر النظام قانونَيْ تجريم التعذيب والإفراج عن معتقلين…. لأن الروس يأملون بالإمساك بتلك الأوراق للمساومة عليها مع الغرب وتركيا خاصة أن شبح إغراق تركيا وأوروبا باللاجئين عَبْر أيّ تصعيد بالشمال السوري يُعتبَر إحدى أدوات الضغط البوتينية….
شاهدنا مؤتمرين لعودة المهجرين عُقدا برعاية روسية كانا أقرب إلى المسرحية الهزلية.. إذ إن الروس لا يقبلون بأي موقف حقيقي يتعلق بعودة لاجئين أو إفراج عن معتقلين دون تنازُلات بإعادة إعمار أو إلغاء بعض المواد المتعلقة بعقوبات قيصر.
أنا أرى أن النظام رمى بتلك الورقة دون رضا الروس بل بدعم وتشجيع من الإيرانيين.
2- نعلم أن النظام السوري وحلفاءه يسعيان لإفراغ المعارضة السورية الرسمية من قوتها الشعبية ومحاولة قضم أراضيها الجغرافية وهو ما دأبت عليه روسيا والنظام وإيران من خلال قضم الأراضي بتفاهُمات أستانة… وذلك لتحويل المعارضة الممثلة للثورة السورية إلى معارضة بدون بُعد شعبي وتواجد جغرافي وتحويل مطالبها لأي معارضة أخرى كالحصول على بعض المناصب الوزارية بحكومة وحدة وطنية أو تعديل بعض المواد غير المؤثرة بالدستور أو ما شابه ذلك.
وإن قرار العفو الأخير يصبّ في هذا الاتجاه بحيث يسحب من يد المعارضة أهم ورقة أخلاقية وسياسية تلقى دعماً من المجتمع الدولي بدوله ومنظماته
3- أن الحديث الذي بدأ يتردد -وخاصة من المسؤولين الأتراك عن منطقة آمنة (غير معروفة المساحة والمواصفات حتى الآن) تتيح عودة طوعية للاجئين سوريين في تركية إلى الشمال السوري المحرر.. وبالتالي الاستفادة من دعم دولي حكومي ومنظمات مجتمع مدني بما لا يتعارض مع مفهوم التعافي المبكر الذي تقره قوانين الأمم المتحدة ..لا يروق للنظام الذي لا يرغب بتخفيف عبء اللجوء التركي عن الحكومة الحالية قبل الانتخابات لتعزيز فرص فوز المعارضة في انتخابات العام القادم والإيحاء النظري بأن مَن يريد العودة بإمكانه العودة لبلدته أو قريته التي خرج منها بإسقاط كل الملاحقات ومذكرات الاعتقال والإفراج عن موقفين وبالتالي لن يعود أحد ويتم إجهاض المشروع الحكومي التركي وتبقى حكومة النظام أيضاً مستفيدة من برامج الإنعاش المبكر لإنشاء بنية تحتية وتأهيل المناطق المدمرة.
لا أعتقد أن لمجزرة التضامن التي كُشف عنها مؤخراً أي دور بإصدار ذلك القانون لأنه صدر في اليوم التالي، وقوانين كهذه تتم دراستها بالأفرع الأمنية والقصر الجمهوري لأشهر على الأقل.
وسيواجه النظام مُكرَهاً ما كان يخشى منه كأحد ارتدادات قانون العفو عليه وهو أن مَن اختُطف ولم تصدر شهادة وفاة بحقه ولم يُفرج عنه… المطلوب من النظام الإجابة عن مصيره ونأمل من الله أن لا يكون ذلك العدد بعشرات الآلاف الذين تمت تصفيتهم خلال الأعوام السابقة.
———————————-
دمشق… الصور تفضح الجلادين/ ناصر السهلي
صور تجمهر الناس في قلب العاصمة السورية دمشق، وعند سجن صيدنايا، بحثاً عن أحبتهم المغيبين منذ سنوات طويلة، لا تضاهيها سوى مشاهد ساحات وشوارع الثورة السورية بين 2011 و2012.
قرر حاكم دمشق بشار الأسد، أن حفرة مجزرة التضامن تحتاج لمشهدين مسرحيين: هتاف “بالروح بالدم نفديك…”، ولا بأس أن يكون في صلاة العيد في مسجد “الحسن” في حي الميدان بدمشق، الذي أخبرتنا قنواته ذات يوم أنه لم يتظاهر، بل خرج ناسه “يشكرون الله على نعمة المطر”، و”عفو رئاسي” عن المخفيين قسراً.
في الحالتين فضحت الحقائق الوجه الحقيقي للديكتاتور “الإنساني والمتنور الحداثي”. فصور آلاف البشر الهائمين على وجوههم، على أمل العثور على “أشباه” أبنائهم، تعني كسراً لتابوهات معادلة القمع: “لا تسأل عمن نخفيه وإلا لحقت به”.
ومنذ عهد الأسد الأب، والمعادلة تقوم على صمت، وبنصيحة “خبراء”، تحت رعب “لا تستفز مخابرات النظام فيأخذوك”، وهو ما خبره السوري والفلسطيني-السوري طيلة عقود.
إذاً، ما شهدته شوارع دمشق، بتقاطر من كل المدن السورية، يضع النظام أمام معضلة: سورية لن تعود إلى ما قبل 2011. لم يعد بمقدور أجهزة القمع القول إن الصور “مفبركة”.
وقد تكون مفاجأة له أن يكتشف السوريون حجم كارثة التهمة الجماعية بـ”الإرهاب”، وأن المصير لم يعد فردياً، بل يمس كل المجتمع، الذي يعيش كارثة حكم بلادهم وفق عقيدة عصابات وقطاع طرق يبتزون جيوب أفقر الناس، بحثاً عن مصير أبنائهم، بعيداً عن حفر المحرقة وصور “قيصر” المسربة.
على حواف التجويع والظلام، وانتفاء شروط الحياة الكريمة، بإمعان أسرة الحكم في الإمساك بالسلطة، باعتبار البلاد مزرعة مملوكة لها منذ أكثر من 5 عقود، لم يعد للناس ما يخسرونه. وتلك معادلة جديدة تُراكم كسر مزيد من المحظورات.
سيكتشف السوريون أن “العفو الرئاسي” لن يعيد لهم مئات آلاف المغيبين قسراً، وأن تهمة “الإرهاب” التي طاولتهم كمجتمع أسست لوضاعة وإجرام المجازر، ولشعارات التطهير تحت بند: “سورية أنحف… سورية أحلى”، تهجيراً وقتلاً وحرقاً.
صحيح أن رياح السياسة الدولية، ورغبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ببقاء النظام، لم تكن في مصلحة شعب سورية. لكن، في نهاية المطاف، ومهما تعمق الاستبداد والقمع، تبقى إرادة الحياة والحرية قاسماً مشتركاً يجمع الناس على مستقبل يزيل ركام الدمار، وكل أهداف الجرائم لتدمير نسيج مجتمعها. والجرائم لا تسقط أبداً بالتقادم.
العربي الجديد
—————————
الرئيس يعفو عن شعبه!
تزايدت في الأيام الأخيرة الأنباء عن مشاريع إصدار رؤساء عرب قرارات عفو عن سجناء رأي ومعتقلين سياسيين ومتهمين بالإرهاب.
يمكن اعتبار التداعيات على قرار بشار الأسد، رئيس النظام في سوريا، مرسوما يقضي بمنح «عفو عام عن الجرائم الإرهابية»، الأكثر إثارة للجدل كونه أدى لحشود بالآلاف في مناطق يتوقعون إطلاق المفرج عنهم فيها.
مشاهد الجموع اليائسة المنتظرة توضح المأساة الهائلة التي يرزح تحتها الشعب السوري، فالعفو «العام» يبدو قابلا للتأويل حسب أمزجة أجهزة النظام المتشابكة، من وزارة العدل، إلى محكمة الإرهاب، إلى السجون وفروع الأمن.
ردود فعل الأهالي وأعدادهم الكبيرة تدلّ على طبيعة العلاقة الفظيعة مع النظام، بدءا من افتراض هؤلاء جميعا أن تهم أبنائهم لابد أن تكون «ارتكاب عمل إرهابي»، فهذه هي التهمة المفضلة لدى النظام السوري ونظرائه العرب، كونها تجعل من الشخص عرضة لكل ما يمكن أن يصيبه داخل السجن أو حتى قبل الوصول إليه، أما تصريحات الجهات الرسميّة السورية، فتدلّ بدورها على أن تنفيذ القرار سيكون بالعشوائية نفسها التي يتم فيها اعتقال المواطنين، وأغلبهم أبرياء، وأنه سيكون محكوما بمصالح أمراء الحرب وقادة الميليشيات والمتنفعين من مآسي السجناء وأهاليهم.
الخبر الثاني كشفت عنه السلطات الجزائرية ويتعلق، هذه المرة، بمشروع مصالحة لـ»لمّ الشمل» مع نشطاء معارضين في الخارج، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، وقد ورد هذا في مقالة تتحدث باسم الرئيس عبد المجيد تبون، عن فتح «صفحة جديدة في الجزائر الجديدة».
طرق تطبيق هذه المبادرة بدت قديمة قدم النظم السياسية، فإحدى الناشطات المعفو عنها تحولت بعد عودتها للجزائر من فرنسا، من مهاجمة السلطة إلى الدفاع عن الرئيس والانتقاد الشديد لـ»معارضي الخارج»، فيما قام معارض سابق بتقديم «اعترافات» في التلفزيون الحكومي يعلن فيها ندمه على «الأفعال التي ارتكبها في الخارج»، وقد كشف معارضون جزائريون أن مفتاح العودة للبلاد يقوم على توقيع تعهدات منها «الإشادة بكل مشروع يهدف لخدمة الصالح العام».
الخبر الثالث كان إعلانا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ»إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي»، وترافق ذلك مع الإفراج عن عدد قليل من سجناء الرأي، وهو ما طال بعض المحكوم عليهم نهائيا، والإفراج عن هؤلاء يجري بقرار من الرئيس شخصيا، وهو ما يدل على أن وجود عطب كبير في العلاقة بين سلطتي الرئاسة والقضاء، وكذلك الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، وهم أشخاص ما كانوا ليبقوا معتقلين سنوات، لو كانت آلة القانون والعدالة في مصر تعمل فعلا!
استثنى قرار الأسد من لم يؤد ارتكابهم «عملا إرهابيا» للقتل، فيما استثنى قرار تبون «من تجاوزوا الخطوط الحمراء» و»أداروا ظهورهم للوطن»، واستثنى إعلان السيسي «من لم تتلوث أيديهم بالدماء».
بالنظر إلى تزامن هذه الاستثناءات مع الكشف عن مجزرة «التضامن»، في سوريا، التي نظّم فيها عناصر مخابرات خطف وقتل وحرق أشخاص أبرياء، ومقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في مصر، واتهام عائلة سجين رأي جزائري للسلطات بقتله «خطأ» هذا الأسبوع نفسه، من حق الشعوب العربية أن تتساءل عمن يجب أن يعفو عن من: الأبرياء المظلومون عن السلطات المتجبرة، أم الرؤساء عن شعوبهم؟
القدس العربي
——————————

«العفو الرئاسي» شمل معتقلين من درعا… وأهالٍ يبحثون عن أقاربهم في دمشق
سجناء سابقون يرون لـ«الشرق الأوسط» مرارات التعذيب
رياض الزين
خرج عشرات من أبناء محافظة درعا من السجون السورية، غالبيتهم تم الإفراج عنهم من سجن صيدنايا، بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد.
وبحسب ناشطين في درعا، فإن المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم حتى الآن، منهم من تم اعتقالهم قبل خضوع المنطقة لاتفاق التسوية في عام 2018، وآخرون تم اعتقالهم بعد التسويات، ثم تطبيق قانون الإرهاب، رغم إجراء اتفاق التسوية عام 2018. وتعددت سنوات اعتقال المفرج عنهم في درعا، فمنهم من قضى 7 أو 5 أو 4 سنوات، وسط غياب واعتقال تعسفي، ومنهم من خرج بحالة صحية سيئة.
«م.م» خرج من المعتقل من سجن صيدنايا مؤخراً بعد مرسوم العفو الذي صدر في سوريا. يروي الشاب (32 سنة) المنحدر من مدينة درعا، تفاصيل من قصة اعتقاله أكثر من 3 سنوات في سجون النظام السوري والأفرع الأمنية في مدينة دمشق، وتعرضه للإهانات والتعذيب الذي سلط عليه وعلى معتقلين آخرين كانوا معه في المعتقلات.
وتبدو مرارة قصته من نحالة جسده والتقيحات الجلدية التي توجد على أطرافه، فسرد من قصته ما يسمى لدى السجانين في المعتقلات السورية بـ«حفلة الاستقبال» وهي حملة تعذيب يشارك بها الراغبون من عناصر الفرع الأمني الذي يتم نقل المعتقلين حديثاً إليه، وفي كل مره كان ينتقل إلى فرع أمني كان عليه وعلى بقية المعتقلين حضور هذه الحفلة التي تنتهي بدماء تسيل من أجسادهم ودموع تنهمر آلماً وصيحات لا تلقى صدى. يقول «فجأة» وجد نفسه خلف قضبان معتقلات النظام السوري في فرع المخابرات الجوية بمدينة حرستا في دمشق بتهم مختلفة، أثناء مروره على حاجز عسكري. بعد اتفاق التسوية، قرر زيارة طبيب في دمشق، وكان قد أجرى عملية تسوية لوضعه في مدينة درعا عام 2018، بعد أن كان مقاتلاً سابقاً في أحد فصائل المعارضة، لكنه تعرض لتهم كبيرة وحكم في محكمة الإرهاب، وتم زجّه في سجن صيدنايا منذ سنتين.
يقول: «وقّعت على كل أوراق الاعترافات للتهم التي قالوها، والتي يرغبون بها تحت التعذيب والضرب، حتى عملية الإفراج الأخيرة كان يتعمد السجانون والمسؤولون في السجن إهانتنا بالكلام، والتفضل بالخروج من المعتقل بتكرمة من الرئيس بشار، كما وصفوها لهم». وقال إنهم وقّعوا على أوراق تعهد بعدم ممارسة الأعمال الإرهابية، ومنهم من جُرد من الحقوق المدنية والعسكرية في سوريا لمدة سنوات تختلف من شخص لآخر بحسب التهم التي بحقه.
في المقابل، ينتظر عامر خروج والده منذ سنوات، «فقد عاد الأمل من جديد لبيتنا»، وأن يكون على قيد الحياة، وإن كان فاقداً للذاكرة. بحسب تعبيره للقاء والده، بعد اعتقال مستمر منذ 10 سنوات،
عامر شاب في عمر الثلاثين، يقول: «قبل 10 سنوات اعتقلوا والدي، وهو عائد من عمله، ولم يكن لوالدي أي توجهات سياسية أو تعاطٍ بالأحداث التي جرت في سوريا، وكان يذهب إلى وظيفته في إحدى دوائر الدولة، لنتفاجأ باعتقاله. والتماطل والمراوغة بكشف مصيره مستمران منذ 10 سنوات حتى من غير أن نراه أو نتأكد حتى الآن من مكان وجوده». وهم من عائلة فقيرة «لا نستطيع دفع المبالغ المالية التي كان يطلبها ضابط وعناصر من الأمن السوري لمساعدتنا في معرفه مصير أو مكان والدي».
يقول، بحسرة في عينيه، في كل مرة يخرج فيها معتقلون «نبدأ عملية البحث والتقصي عن والدي، وكل مرة نذوق لوعة الخيبة، ونتأمل في هذه المرة أن يعود، وأن تكون ردة فعل دولية ضغطت على النظام السوري بعد التصفية العشوائية التي بثّتها صحيفة الغارديان البريطانية في شريط مصور، يعرض أحد عناصر النظام السوري، وهو يقوم بتصفية 41 شخصاً في منطقة التضامن بالعاصمة دمشق، وقال معارضون إنها عملية تصفية وانتقام نفذها عناصر من الأمن السوري بحق مدنيين من سكان دمشق. وتفسر حال عامر في انتظار والده حال كثيرين من أبناء درعا وسوريا الذين عانوا ويلات الحرب والاعتقال والغياب القصري».
وقال الناشط مهند العبد الله، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن مئات العائلات في درعا تنتظر بعد مرسوم العفو الرئاسي عن المعتقلين خروج أبنائهم من الاعتقال، ومنهم من غادر إلى دمشق بحثاً عن معتقليه لعله يجده، بعد خروج كثيرين فاقدين للذاكرة، ومنهم من لا يزال ينظر منذ أكثر من 10 سنوات، وسط اتجاه من الأهالي إلى المحامين للاستفسار عن مصير أبنائهم المعتقلين.
وعن إمكانية شموله ضمن العفو الذي صدر مؤخراً في سوريا، والذي قضى بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين، قال: «لم تتضح أعداد المُفرج عنهم في محافظة درعا حتى اللحظة، والعشرات من أبناء مدن وبلدات محافظة درعا بدأوا بالخروج من السجون منذ الأول من مايو (أيار) الحالي، وعدد كبير من المفرج عنهم في محافظة درعا كان ذووهم قد سجلوا أسماء المعتقلين لدى الجانب الروسي حين افتتاح مراكز التسويات أو خلال الجولات التي كانت تجريها القوات الروسية في مناطق التسويات».
وتداول ناشطون في سوريا عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً، قالوا إنها توضح مدى المعاناة التي يعيشها السوريون والأعداد الكبيرة للمعتقلين في سوريا، وأظهرت الصور تجمع أعداد كبيرة من الأهالي في العاصمة دمشق في منطقة «جسر الرئيس» وبعض مناطق في مدينة حمص وحماة، وهم في انتظار الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، من الذين شملهم قرار العفو الرئاسي.
ودعت وزارة الداخلية في سوريا المواطنين في تصريح لجريدة «الوطن» شبه الرسمية في سوريا لـ«عدم الانتظار» تحت منطقة «جسر الرئيس» أو في أي مكان آخر للقاء ذويهم؛ حيث لم تخصص الوزارة أي مكان محدد لتجميع المفرج عنهم ممن شملهم العفو، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من المفرج عنهم قد غادر السجن مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال وسيلة أخرى. وأكدت أن كل ما ينشر على بعض الصفحات عن مواعيد ومناطق تجمع لا أساس له من الصحة.
ومن جانبها، أعلنت وزارة العدل في سوريا أنه تم خلال اليومين الماضيين إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات في سوريا، على أن يتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب، إضافة إلى عدد من الموقوفين الذين تم الطعن بقراراتهم، وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين المقبلين. كما أكدت «وزارة العدل» أن جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام المقبلة.
—————————-
النظام يطلق المزيد من المعتقلين..”ثلاثة أرباعهم حرامية“
أطلق النظام السوري سراح دفعات جديدة من المعتقلين السوريين ليل الخميس/الجمعة، في إطار العفو الذي أصدره الأسد عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان/إبريل 2022. وجرى تجميع المعتقلين في مباني محافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة واللاذقية قبيل تسليمهم إلى ذويهم.
وبثّت وسائل إعلام رسمية ورديفة للنظام صوراً ومقاطع مصورة لتجمع عشرات المعتقلين بينهم نساء في مبنى محافظة دمشق في حي المرجة وسط العاصمة دمشق، بحضور عدد من الشخصيات الحزبية والمسؤولين المحسوبين على النظام، من ضمنهم محافظي دمشق وريفها.
وقال محافظ ريف دمشق عبد الناصر جمران خلال الاجتماع مع المُفرج عنهم، إن “عدد الذين تم الإفراج عنهم هو 99 معتقلاً بموجب العفو الأخير”، موضحاً أنه سيتم تسليمهم إلى ذويهم عن طريق الوحدات الإدارية أو بشكل مباشر من ذات المحافظة، مشيراً أن “الأمور تسير بشكل جيد ومنتظم”.
من جانبه قال موقع “سناك سوري” المقرب من النظام السوري إن 50 معتقلاً من محافظة درعا وصلوا إلى مبنى المحافظة، مشيراً إلى أن المعتقلين كانوا في معتقلي صيدنايا العسكري وعدرا المركزي. وأضاف أنه تم تسليمهم إلى ذويهم من أمام المبنى.
بالمقابل، قال الناشط من مدينة درعا محمد عساكره “إنه بمقارنة أسماء المفرج عنهم ببيانات مكتب توثيق المعتقلين في تجمع أحرار حوران، اتضّح بأن جميع المفرج عنهم هم ممن جرى اعتقالهم بعد تسوية تموز/يوليو 2018”. وأضاف أن من بين المفرج عنهم 17 مجنداً من قوات النظام، إضافة إلى وجود 13 شخصاً من المجموع الكلي اعتقلوا في وقت سابق بتهم جنائية تنوعت بين السرقة وتجارة المخدرات.
ولفت الناشط إلى أن النظام السوري يتلاعب بمشاعر الأمهات والآباء كون المفرج عنهم لا علاقة لهم بالرأي والحرية والثورة السورية قائلاً: “ثلاث أرباع المفرج عنهم حرامية”.
وفي هذا السياق، قال محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل لإذاعة “شام إف إم” الموالية، إن “عدد الذين أطلق النظام سراحهم بلغ من محافظة القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي بلغ 30 معتقلاً”، مضيفاً أن دفعات جديدة سيتم الأفراج عنها لاحقاً.
وأكدت الإذاعة الموالية وصول 30 معتقلاً أفرج عنهم النظام السوري من محافظة حلب وصلوا إلى مبنى القصر البلدي في وسط المدينة لتسليمهم إلى ذويهم عبر الجهات المعنية، إضافة إلى وصول 6 آخرين إلى مبنى محافظة اللاذقية.
وبالموازاة، وثقت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا إطلاق النظام لسراح 103 معتقلين من السجن العسكري، كما وأطلقت الرابطة حملة استجابة طارئة للرد على استفسارات الأهالي، وتقديم الدعم النفسي، إضافة إلى المساعدة في عملية البحث عن ذويهم وتقديم المشورة لتجنب تعرضهم لعمليات احتال وابتزاز في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد الذين أفرج النظام السوري في سياق العفو الأخير ارتفع إلى 426 معتقلاً، مضيفاً أن العدد ضئيل جداً مقارنة بعشرات الآلاف في سجونه ومعتقلاته، مطالباً في الوقت ذاته النظام بالكشف عن زهاء 97 ألف معتقل في سجونه، تمكن المرصد من توثيقهم منذ بداية الثورة السورية في آذار/ مارس 2011.
—————————
الإذلال والعدم تحت جسر الرئيس/ علي سفر
قبل أن تأتي الأوامر بإخلاء كراج الانتظار الكبير، تحت جسر الرئيس في دمشق، من الجموع الغفيرة المحتشدة فيه، علينا أن ننتبه إلى أنها المرة الأولى في تاريخ النظام، التي يجتمع فيها هذا العدد الكبير من كارهيه، في مكان واحد، من دون أن يقوم بتعذيبهم جسدياً كما في الفروع الأمنية، أو من دون أن يفلت عليهم قطعان الشبيحة والقوى الأمنية ليمعنوا فيهم ضرباً وركلاً، أو من دون أن يجعل قناصيه يستهدفون رؤوسهم برصاصهم القاتل أيضاً!
لا حاجة لأن ندلل على هذه الفكرة بتذكر أمثلة عما حدث سابقاً من مجازر يومية أثناء العامين الأوليين للثورة، لكن ربما نحتاج لأن نلفت انتباه من يقرأ إلى أننا لا نستطيع نفي تعرض كل الموجودين هناك إلى تعذيب نفسي، يجعلنا نفكر بالكينونة العصابية الخرقاء لمن جعل هذا يحدث.
الوقوف تحت هذا الجسر، حيث تحتشد سيارات السرفيس التي تنقل البشر من وإلى مناطق سكنهم، كان مرهقاً في الأيام العادية، فكيف هو الحال بعد كل هذا الخراب؟ كيف يمكن لعائلات المعتقلين أن تقبل الوقوف عند مكان يذكرهم اسمه بمن فعل بهم كل هذا؟!
من الواضح أن القصة لم تحدث بلا تخطيط، فمن طقوس المكان أن تكون الأفعال كلها سريعة، حيث يأتي الشخص لينتظر قليلاً السيارة التي ستقله من المكان، ثم يمضي، لكن ذلك لا يمنع أن يصبح الازدحام كبيراً، طيلة ساعات النهار، فكيف حدث أن سرت بين الناس فكرة أنهم هنا سيرون أحبّتهم الغائبين؟! المكان لا يحتمل طقوساً كهذه، كما أن من سيطلق سراحهم بموجب العفو الرئاسي عن جرائم الإرهاب، لن يأتوا إلى هنا من بيوتهم، بل من اللا مكان، فلا أحد يعرف إن كانوا في سجن صيدنايا أو عدرا، أم في أقبية الفروع الأمنية، أو من معتقلات سرية ومجهولة! وهم أنفسهم لا يعرفون إن كانوا سينجون من مصيرهم التعيس، أم أنها خدعة تشبه ما عرفناه قبل أيام من شريط مذبحة التضامن، حيث كانوا القاتل يخدع الضحايا بالقول لهم أن يركضوا لينجوا من القناص المتربص بهم، ولينتهي المشهد بهم وقد سقطوا في الحفرة مضرجين بالدماء!
القفص المعدني
السوريون الذين كانوا متأكدين من أن معتقلَيهم سيُطلَقون هنا، كانوا يجرون من مسرب إلى آخر، مع مرور أي سيارة مختلفة عن السرافيس، كما أنهم لحقوا بسيارة شرطة عسكرية، من نوع القفص المعدني الذي يُحشر فيه المعتقلون والموقوفون، قيل لهم بأنها ستتوقف في ساحة المرجة!
المشهد الغرائبي ليس طريفاً، ولا يصلح لأن يحكى عنه في سياق سرد قصصي أو روائي، إنه في الحيثيات الخبرية مزعج ومفزع، فكيف سيكون لو أضاف عليه الكاتب شيئاً من القباحات المتوقعة عن عالم الأسديين!
كنتُ ذات مرة سجيناً يتم نقله في مثل هذه السيارة، تم تكبيل معصمي بالقيد المعدني الذي مرّرتُ فتحته الأخرى بعمود معدني ممتد من أعلى باب القفص حتى نهايته، لكنني حاولت أن أرى شوارع المدينة، فأصابني ألم شديد بسبب ضغط حديد القيد على يدي مع تأرجح جسمي بفعل قيادة السائق الرعناء، لكن الألم الأكبر جاء من رؤيتي للناس يعبرون ولا يبدون مكترثين بالسيارة ومَن فيها!
لكن الآن، وفي اللقطات التي صورها أحد الحاضرين، كان البشر الذين مرّت بينهم السيارة مكترثين جداً، إلى درجة أنهم ركضوا وراء العربة مسافة طويلة، هؤلاء كانوا في العام 2011 أطفالاً وعاشوا الخسارات كلها، من فقدان الآباء والأخوة في المجهول وحتى تحول حياتهم كلها فقداناً ومجهولاً، في سوريا التي باتت ثقب العدم. أمهات قرويات قدمن من المحافظات القريبة، القنيطرة، درعا، ريف دمشق، يرتدين ملابسهن التقليدية، وفجأة يجدن أنفسهن مضطرات لأن يركضن وراء سيارة مكتظة بالسجناء!
يبدو أن شخصاً ما يتابع المشهد مستمتعاً، ربما يكون الرئيس بذاته، بحسب تخمينات البعض في صفحات التواصل الاجتماعي، الذين قالوا: إن إذلال السوريين، وتحديداً عائلات المعتقلين الذين عاشوا سنوات ينقبون عن الأمل برؤية مفقوديهم بهذا الشكل الجماعي، لا يمكن أن يكون في هذه اللحظة مسألة روتينية.
تقنين الإذلال
لقد تم الانتقاص من كرامتهم مرات ومرات، وأمام كل باب طرقوه محاولين الحصول على معلومات عن أولادهم، لكن سياسة النظام كانت تقتضي بتقنين الإذلال، وجعله حدثاً يومياً بالمفرّق، ولهذا فإن حشد الناس بهذه الطريقة ليس قراراً هيناً، بل هو قرار لا يمكن أن يتخذه سوى شخص واحد في البلاد! ولعل القرينة الثانية التي تدلّ على الجريمة هي المكان بذاته، تحت جسر الرئيس، بما يحمله من علامة سلطوية!
إنه المكان الأبشع في المدينة كلها، رغم أنه يحوي أكبر بسطات الكتب السورية، ففيه تتحول حياة السوريين إلى حضور عابر، لا يبقى منه سوى الخواء ورائحة عوادم السيارات، وفي بعض زوايا المكان كان البعض يقضي حاجته، ليشارك برائحة النشادر في الحفلة القاتمة للعاصمة. بين الجدار الغربي للمتحف الوطني، والأرض المتروكة من بقعة دمشقية جميلة، أقيم لعقود معرض دمشق الدولي، قبل أن يُنقل إلى مدينة المعارض في طريق المطار، وقبل أن تتصارع جهات من حاشية النظام على الاستحواذ على هذه الأرض الثمينة تجارياً، ولينتهي الأمر إلى يد السيدة الأولى وهي تمتد لتأخذه، ولتشيد عليه مشروع الوردة الدمشقية، الذي توقف منذ بداية الثورة، وبقي الجزء المنجز منه قائماً، يشبه فوهة زهرة وحشية تترصد فريستها قبل أن تزدردها!
ظهر عدد غير قليل من الجموع المنتظرة في تقرير بثته إذاعة “شام إف أم” الموالية عبر السوشال ميديا ثم حذفته، احتجوا فيه على إذلالهم المتعمد، وعن كونهم قد سئموا الانتظار، وعن الأماكن البعيدة التي قدموا منها، والبيوت المتروكة من دون عناية في أيام العيد بانتظار الفرج. وفي السياق، كشف شاب أنه ينتظر والده المعتقل منذ عشر سنين، وقالت امرأة أنها تنتظر ابنها وزوجها، فيما اشتكى شاب صغير من سرقة هاتفه الجوال وسط الزحام! كانوا يحكون أمام الكاميرا وكأنهم ينتظرون أمام مؤسسة تموينية، توزع إعاشات أمام فرع الهجرة والجوازات!
إحساسهم بأن ما يجري هو تفصيل من سياق طبيعي، لا يخفى. وكأنهم يسربون لمن لا يعرف أنهم يعيشون في طقوس العادي، رغم نبرة الاحتجاج! فهنا تتساوى أكبر القضايا مع أصغرها، طالما أنها تمر تحت السقف، وهو هنا ليس أي سقف، بل سقف تحت جسر الرئيس!
كما في المعتاد من حياة السوريين، يمكن لأي منهم أن يحتج على نقص المواد، وعلى قطع الكهرباء، واختفاء المشتقات النفطية، ومن المسموح له أن يرفع الصوت عالياً، إلا قليلاً، لكي لا يصل إلى حيث “قائد الوطن”. لكن هنا، ولأن القضية مرتبطة بمكرمة “سيد الوطن”، لا بأس بترك البشر تعبّر عن غضبها، لكن ليس إلى درجة الإنفلات! ففي السياق العادي أيضاً كل شيء مضبوط ومحسوب!
كان يمكن لدورية أمن واحدة أن تمنع كل هذا. ففي بلاد الرعب، أربعة مسلحين بسحنة رجال مخابرات يستطيعون أن يخيفوا عشرات الآلاف من البشر البسطاء، لكن دمشق الروعة بسطوة هؤلاء، عاشت فوضى وإغماضاً للأجهزة عما يجري، ليومين أو ثلاثة، قبل أن تحاول وزارة العدل التخفيف من اندفاع الناس صوب المكان، عبر الإعلان أن إطلاق الموقوفين بعد “مكرمة العفو”، لن يتم في مكان محدد، بل يمكن أن يجري في أي بقعة في البلاد، فكل الأمكنة مناسبة للقيام بذلك!
ولهذا، يعاود ناشطون التأكيد على أن ما جرى في وسط دمشق، طيلة الأيام السابقة، لم يكن سوى فصل جديد، مكتوب بعناية في حكاية قهر مستمر منذ عقود، ولا يبدو أنه سينتهي!
المدن
————————————-

يرميهم في الشوارع بلا ذاكرة أو مال… هكذا يفرج نظام الأسد عن معتقليه/ كارمن كريم
حوالى 5000 سوري افترشوا الطرق في صورة قاسية للمأساة السورية، إحدى الأمهات نامت عند سجن صيدنايا وحين فقدت الأمل انتقلت إلى منطقة جسر الرئيس، آلاف الأبرياء ما زالوا يقبعون في الداخل
يقف المعتقل الذي أُفرج عنه منذ بضع ساعات مذهولاً وسط الجموع، تقترب امرأة منه وهي تحمل صورة صغيرة لابنها أو زوجها، لا نتمكن من تحديد صاحب الصورة، تمدُّ يدها المتجعدة إلى وجهه، فيما يمد البعض هواتفهم بغية عرض صور أحبائهم وسؤال المعتقل عنهم، فقد يكون التقاهم في السجن أو ربما يعرف أي خبر عنهم، مشهد يختصر مأساة المعتقلين والمغيبين قسراً داخل أقبية النظام السوري.
لا قوائم رسمية حتى الآن
آلاف العائلات انتظرت عفواً عاماً عن المعتقلين، حتى لو كان تحت اسم عفو عن جرائم الإرهاب، مع يقينهم بأن أبناءهم ليسوا إرهابيين، إنها عائلات متعطشة لخبر صغير أو لبارقة أمل تقول لهم إن أبناءهم ما زالوا يتنفسون في مكان ما، أمنية حرمهم النظام منها طوال سنوات وحتى حين لوّح بأمل قريب، فقد جعله ثقيلاً وغامضاً وغير مؤكد.
كان الأسد أصدر نهاية شهر نيسان/ أبريل عفواً عاماً عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها سوريون قبل 30-4-2022، باستثناء تلك التي أفضت إلى موت إنسان، وكان القاضي نزار صدقني معاون وزير العدل قال في تصريح إن المرسوم شمل جرائم مختلفة منها العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن، لذلك جاء إلى مختلف أنواع هذه الجرائم، ولا حاجة ليراجع المشمولون بالعفو الدوائر الرسمية، فمؤسسات الدولة ستقوم بالإجراءات بشكل فوري. وبحسب وزارة العدل تم خلال الأيام الماضية إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، ويعتبر العفو غير مسبوق فلا يشترط أن يسلم المطلوب نفسه للعدالة، وبإمكان كل قاضٍ أو وكيل نيابة أو موظف معني بما في ذلك الأفرع الأمنية، تطبيق العفو.
حتى الآن، لا قوائم رسمية وكل ما يصل إلينا هو أخبار متفرقة من هنا وهناك دون تأكيدات واضحة، ما يثير مخاوف من عدم جدية النظام في تطبيق القرار، أليس من حق عائلات المعتقلين والمغيبين قسراً معرفة حال أبنائها على أقل تقدير؟ ألا يحق للمعتقلين إخبار عائلاتهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة؟
معتقلون مرميون على الطرق
الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لمن أفرج عنهم تعكس رعب ما كان يحدث في الداخل، فالنظام لم يكتفِ بإخراج المعتقلين ورميهم في شوارع دمشق من دون مال أو طريقة للتواصل مع ذويهم، فهو لم يعلم عائلاتهم حتى! وبذلك واصل استهتاره بآلام السوريين، متعاملاً مع المعتقلين، حتى في لحظة خروجهم، بطريقة لا أخلاقية ولا إنسانية. وبحسب الصور التي انتشرت للمعتقلين، كانت وجوههم شاحبة، عيونهم مذهولة، وعظام أجسادهم نافرة. كما انتشرت صورٌ لمعتقلين فقدوا الذاكرة على “فيسبوك” في محاولة للوصول إلى أهاليهم.
بعض هؤلاء دخلوا المعتقل مع بداية الثورة عام 2011 واليوم يخرجون ليدركوا أن الأشياء تغيرت، هناك ربما من لن يجدوا عائلاتهم التي قُتلت أو هُجّرت والبعض لن يجد منزلاً يعود إليه. عشر سنوات ليست مجرد وقت مضى إنما هي أرواح أزهقت ومنازل قصفت وأحياء دمرت عن بكرة أبيها، إنهم معتقلون لم يكونوا مغيبين في أماكن بعيدة إنما قريباً جداً من العاصمة السورية وربما قريباً جداً من أحبائهم، ماذا لو لم يجد المعتقلون عائلاتهم أو أي منازل يعودون إليها؟ ماذا سيفعلون وسط العدم من دون عمل أو معين؟ وبذلك يشكل القرار إدانة للنظام وأجهزته، فهؤلاء الشبان وكبار السن الذين خرجوا فاقدي الذاكرة أو بمشكلات نفسية وجسدية هم دليل على وحشية نظام الأسد وما يحدث داخل سجونه من تعذيب وإهانة ومعاملة لا إنسانية.
وبحسب دياب سرية مؤسس رابطة “معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” فالعفو هو الأول من نوعه، بعد عفو عام 2014 والذي لم يكن بهذه الشمولية، إذ اقتصر على العساكر والضباط المنشقين، وبحسب الرابطة بدأ إخلاء سبيل المعتقلين بالفعل وهوما يثير الاستغراب، خوفاً من وجود مخطط في رأس النظام، وبخاصة بعد إصدار قانون مكافحة التعذيب، في مخطط أكبر ربما يسعى من خلاله لإثبات الإصلاحات والتغييرات السياسية التي يقوم بها الأسد. وهي برأي دياب إجراءات شكلية وتجميلية، ولكن من جهة أخرى، هي طريقة للضغط على اللاجئين في الخارج ودول الجوار كتركيا، إذ إن الأسد أصدر عفواً وبإمكانهم العودة، لأن العفو يشمل أيضاً المتوارين على الأنظار لكن هذا الكلام يثير الشكوك، إذ لا يمكن تصديق هذا النظام، لا سيما في ظل الضبابية السياسية الراهنة.
هل تقطع العائلات الأمل؟
بعد بدء الإفراج عن المعتقلين توافد آلاف السوريين إلى منطقة جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، بانتظار الحصول على معلومات عن ذويهم أو مقابلة أبنائهم الذين أفرج عنهم، ليبدو المشهد كمهرجان أو احتفالٍ لكن للأسف لم يكن كذلك، إنها عائلات وأبناء ورفاق ينتظرون ولو خبراً، لقد ترك النظام الناس معلقين على حبل الأمل واليأس من دون أن يعرفوا إن كان ذووهم أحياء أو موتى، فيما النظام لم يكلّف نفسه عناء نشر لائحة بأسماء المفرج عنهم.
تبكي فتاة خلال لقاء مع قناة “شام أف أم” الموالية قائلة إن أخاها وأباها معتقلان منذ 9 سنوات، ولا تريد العائلة سوى معرفة إن كانا على قيد الحياة… حوالى 5000 سوري افترشوا الطرق في صورة قاسية للمأساة السورية، إحدى الأمهات نامت عند سجن صيدنايا وحين فقدت الأمل انتقلت إلى منطقة جسر الرئيس، آلاف الأبرياء ما زالوا يقبعون في الداخل، آلاف ألصق النظام بهم تهم الإرهاب خلال حملات اعتقال عشوائية وبخاصة بين عامي 2012 و2014، والتي طاولت مئات المدنيين بهدف القضاء على الثورة في أقصر وقت ممكن.
الاف العائلات السورية تعيش على أمل التعرف على صورة ابن أو اب او قريب ويبحثون عمن يخبرهم أن آحبائهم مازالوا أحياء لكن نظام الأسد يتلاعب حتى بهذا الأمل فيخرج مدنيين فاقدين للذاكرة، في صورة متناقضة للحالة السورية اليوم التي مازال نظام الأسد مصراً على جعلها تراجيدية حتى في لحظاتٍ يفترض بنا الفرح فيها.
درج
———————————

عفو الأسد ليس “مكرمة”.. بل هو القهر بعينه/ وليد بركسية
أفضى العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد عن بعض المعتقلين والمغيبين قسراً ممن نجوا حتى الآن بعدما زجوا في المعتقلات وعانوا من التعذيب النفسي والجسدي من دون أن يعرف عن مصيرهم أحد، إلى معضلة في موقف الشارع الموالي والإعلام الرسمي وشبه الرسمي. لأن خطاب النظام إعلامياً ودبلوماسياً طوال سنوات كان يكرر على فكرة عدم وجود معتقلين من الأساس في البلاد، مع إطلاق أوصاف عليهم كالموقوفين والسجناء وكلها أوصاف قانونية تختلف بشكل جذري عما يحصل في البلاد حرفياً.
ومع نزول آلاف السوريين إلى شوارع العاصمة دمشق وتجمعهم في منطقة جسر الرئيس انتظاراً لوصول معتقلين إلى هناك، شكل المشهد صدمة للموالين لسببين الأول هو الإنكار التام لوجود قضية معتقلين في الدولة الأسدية التي تزعم أنها دولة مؤسسات يحكمها القانون، والثاني هو الأحقاد المجتمعية التي ولدتها الحرب السورية، أو زادت من حدتها ويرى أصحابها بموجبها المعتقلين وعائلاتهم مجرمين وإرهابين لا يستحقون الإفراج عنهم.
ولم يكن من الغريب بالتالي أن تصور شبكة شام “إف إم” تقريراً بالفيديو عن تلك التجمعات قبل حذفه لاحقاً بسبب كمية الإحراج لسردية النظام الكاملة، ظهر فيه أفرادلم يعد في عيونهم دموع للبكاء يستجدون من أجل معلومة واحدة حول مصير أب أو أم أو أشقاء أو صديق أو حبيب. هم لم يتجمعوا هناك لأنهم يدركون مسبقاً أن من ينتظرونه سيأتي حتماً، بل كانوا هناك على أمل يائس بأن ذلك سيحدث، أو للحصول على معلومة من الناجين في حال كانت ذاكرتهم سليمة، حيث انتشرت قصص وصور محزنة لمعتقلين خرجوا أخيراً وبدوا أشبه بجثث بشرية بعد سنوات وسنوات من التعذيب، لدرجة فقد بعضهم ذاكرتهم كلياً جراءه.
وعلى “الإخبارية السورية” وصف قضاة ومحامون ومذيعون، الأهالي بأنهم خونة ومندسون ومدفوعون من جهات خارجية. كيف يمكن لهم أن يشوهوا عظمة العفو الرئاسي، يتساءل أحد القضاة، ويستغرب من مشهد التجمعات بوصفه مشهداً غير لائق و”لا يراعي الأصول”، وتوصلوا جميعاً باستهجان إلى خلاصة بأن من ينزل إلى الشوارع هم “أشخاص بلا عقل ولا منطق” لأن العرف والقوانين المعنية لا تنص على إصدار قوائم ومعلومات عن المعتقلين، وهم أمر ممنهج بالطبع من أجل إحداث مزيد من القهر وكسر النفسية المعروف كاسلوب كلاسيكي للحكم ضمن أي نظام شمولي.
ورغم أنها صور نظيفة، أي خالية من الدم والعنف والأشلاء البشرية التي تأتي إلى الذهن مباشرة عن التفكير بفظائع الحرب السورية، فإن صور المعتقلين وعائلاتهم التي تنتظرهم على حد سواء، مخيفة لدرجة تعجز الكلمات عن وصفها، خصوصاً أنها تظهر بوضوح معنى الحياة في ظل نظام دكتاتوري مجرم يعاقب المدنيين بلا سبب غالباً بالتعذيب ويخفي كل معلومات عنهم عن عائلاتهم ويبتز عواطف تلك الأخيرة من أجل تخويف القسم الباقي. وحتى في سياق مفرح نظرياً يتعلق بالإفراج الذي يعني العودة للحياة من الموت، فإن النظام يحرص على تحويل تلك المشاعر إلى خليط من الإذلال واليأس لدرجة يمكن معها سماع صوت الأسد شخصياً يصرخ من وراء الصور متخطياً حدود الزمان والمكان: “فعلت هذا بهم ويمكنني أن أفعله بكم أيضاً حتى إن كنتم من الموالين لي وتجرأتم على القيام بما لا أرضاه”.
على أن القهر الذي تحمله صور أهالي المعتقلين المتجمعين في شوارع دمشق، يتخطى قدرة الكلمات على الوصف. كيف يمكن الكتابة عن شعور أم تنتظر خبراً عن ابنها المعتقل منذ 11 عاماً ولا تعرف عنه شيئاً إن كان حياً أم ميتاً؟ وكيف يمكن التعبير عن فتاة شابة لا تذكر من أبيها سوى ظله هو الذي اعتقل عندما كانت طفلة صغيرة؟ وكيف يمكن رصد اللهفة والأمل واليأس والحسرة والبؤس كلها معاً أمام مقاطع الفيديو للتجمعات التي يشكر فيها الأهالي خاطف أحبابهم على إمكانية إطلاق سراح أحبابهم؟ وكيف يمكن الهرب من الشعور الخفي بالراحة مع البعد الجغرافي عن المكان المظلم المدعو سوريا الأسد الذي يتسلل حتماً إلى قلوب الناجين في الخارج متحولاً بسرعة إلى إحساس بالذنب لا يزيله التضامن المعنوي مع من بقي تحت رحمة النظام المجرم.
والحال أن صور المعتقلين وحملة التضامن مع عائلاتهم التي كانت رائجة في الأيام القليلة الماضية كسرت كل ما يروجه النظام عن نفسه بأنه دولة قانون ومؤسسات، أمام حتى الموالين له الذين كانوا إن أبدوا تعاطفهم مع صورة ما واجهوا اتهامات فورية بالخيانة من قبل موالين أكثر تشبيحاً على ما يبدو. وبدا للحظة أن توجيهات رسمية أعطيت إلى الصفحات المخابراتية والشخصيات الموالية الناشطة في مواقع التواصل لضخ معلومات معاكسة، تفيد بأن “العفو الرئاسي مكرمة يجب شكر القائد المفدى بشار الأسد عليها”، وأن “الرئاسة السورية مثل الشعب السوري تقدس القرآن الذي ينص على العفو عند المقدرة حتى عندما يتعلق الأمر بخونة ضلوا طريقهم” وهي عبارات وجدت طريقها إلى نشرات الأخبار الرسمية ايضاً.
وبشكل أكثر دناءة ربما كرر موالون عبارات مثل “دام عزك يا أسد” مطالبين الأهالي بتكرار العبارات نفسها، كما انتشرت منشورات من الشعر الركيك تحيي عظمة الأسد التي تفوقت على “طائفية المعارضة وحقدها وكذبها” حيث “استطاع “بيديه الطاهرتين سحب سكاكينهم” وتم تأطير العفو بأنه ضرورة كي تعود البلاد إلى حالتها الطبيعية بالمسامحة وتجاوز الماضي، وهي دعوات كانت رائجة منذ الأسبوع الماضي عندما كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية عن مجزرة مروعة في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق راح ضحيتها مئات المدنيين.
وفيما كان الموالون يذكرون بانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان قامت بها فصائل جهادية في سوريا للقول أن “الطرفين غلطوا” وأن النظام وحده من يسامح، فإن تلك المقاربة تخلو من المنطق بغض النظر عن أخلاقيتها أصلاً حيث لا يمكن تبرير جريمة بجريمة. والمشكلة هنا تتعلق بحجم الانتهاكات واستمراريتها، والنظام من ناحية كونه يحكم البلاد بأسلوب بوليسي يمارس إرهاب الدولة بحق مواطنيه منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة في انقلاب عسكري العام 1970، وتتكرر صور وحكايا المعتقلين منذ عقود وليس فقط بعد الثورة السورية، وخصوصاً في فترة الثمانينيات الظلامية. ويكفي القول أن سوريا الأسد قدمت للعالم نماذج للرعب المعاصر مثل سجن تدمر سيئ السمعة أو سجن صيدنايا العسكري الذي تصفه منظمة العفو الدولية “أمنستي” بـ”المسلخ البشري” وبأنه “أسوأ مكان على الكوكب”.
ويبقى عدد المفرج عنهم غير معروف تماماً ويقدر بأقل من مئتين شخص فقط حتى الأربعاء، لكنه يبقى ضئيلاً حتى لو لم تتوفر أرقام دقيقة عن عدد المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام، حيث تقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين بـ132667 فضلاً عن 86792 من المغيبين قسرياً، وهو فصل لا بد منه عند الحديث عن ظروف الاعتقال في البلاد، لأن النظام يعمد إلى استخدام أساليب قهرية مضاعفة عبر حالات الاعتقال التي لا يتم الإفصاح عنها أو الاعتراف بوجودها، من دون توفير أي معلومات عن المغيبين قسرياً لعائلاتهم.
——————————–
الإفراج عن المعتقلين “خطأ قانوني”/ فاطمة ياسين
ضجت دمشق واشتعلت الساحة الواسعة تحت الجسر الواصل بين شارع الأرجنتين وشارع مسلم البارودي والمار فوق شارع شكري القوتلي، الذي يطلق عليه شعبيا اسم جسر الرئيس.. ملأ الساحة بكثافة أناس مكتئبون يتشاطرون هما مشتركا هو فقدان فرد أو أكثر من أفراد العائلة تحت عنوان مرعب هو الاعتقال.. كانت مناسبة التجمع الغفير مرسوم أصدره بشار الأسد “بالعفو العام” عن المدانين بجرم إرهابي، بالتأكيد لم يفكر ذوو المجتمعين تحت الجسر بالتسمية المجحفة، بل بعزيز تم اختطافه ليلا، أو نهارا، من منزله أو من الشارع أو من عمله، واقتياده إلى جهة مجهولة، دون أن يُعرف إلى أين وإلى متى. يريد النظام في كل مناسبة أن يظهر نفسه كمؤسسة تعمل وفق القانون فتصدر عبر رئيسها مرسوما حكوميا تعفي فيه عمن مارس الإرهاب بحقها.
بعد أن اشتعل الحراك في سوريا بداية العام 2011 ثم عمت المظاهرات أنحاء البلاد، دخل المجتمع السوري في حالة من الفوضى حين عمم النظام أسلوب مهاجمة المظاهرات الذي قامت به مجموعاته من رجال الأمن والشبيحة بالأسلحة والرصاص، وبعد تحول المظاهرات إلى شكل من أشكال المقاومة الشعبية ضد هجوم رجال الأمن والشرطة ومن معهم من مجاميع مسلحة استباحت كل شيء، أصدر بشار الأسد في الشهر السابع من عام 2012 قانونا سمي القانون رقم 19 الخاص بمكافحة الإرهاب، وصف فيه تهمة الإرهاب وعرف الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب، وقد حرص أن تنطبق هذه التعريفات على من يخرجون في المظاهرات، ومن يتحدون النظام بالوقوف في وجهه أو ممن يجاهرون بموقفهم المعارض لسلطته ورجاله المدججين بالكراهية وحب القتل، وبموجب القانون المذكور أصبح كل فعل يمت للمعارضة بصلة، يعرِّض صاحبه للحكم، سواء أكان سلوكه اعتراضا أو تظاهرا أو كتابة منشور أو حمل سلاح، وتراوحت مدد أحكامه من عشر سنوات تدرجا إلى الإعدام مع المصادرة الباهظة للممتلكات، وربما كان مُنشئ القانون يدرك أن الليرة السورية مصيرها التدهور فلم يذكر مبالغ مالية محددة بل اقتصر على أن الغرامات هي ضعف قيمة المواد “الإرهابية” المصادرة!.
رغم غموض هذا القانون وعمومية مواده وميادين تطبيقه فإن رجال الأمن والقضاء التابعين للنظام كانوا يعرفون ما عليهم تنفيذه، وهو حشر كل من يُقبض عليه بعد إصدار هذا القانون في السجن، وكتحصيل لحاصل سيبقى مسجونا مدة عشر سنوات، وهي أقل مدة سجن يتحدث عنها القانون. تم تنفيذ هذا القانون الفضفاض بكل حزم وقسوة حتى امتلأت السجون عن آخرها، وكان النظام يغطي موقفه القانوني بتبرير هذا العدد الكبير من السجناء، من خلال قانون واسع الأكمام رقمه 19 لعام 2012. حَرصَ النظام على إضفاء الشكل المؤسسي على تصرفاته مهما كانت موغلة في الوحشية والعنف، ومنها الاعتقال الجماعي الذي طال أكثر من خمسة في المئة من مجموع عدد سكان سوريا وبموجب قانون واحد جامع مانع.
لم يدرك النظام “المؤسسي” أن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره هو مرسوم غير دستوري بموجب الدستور الذي أصدره بنفسه بعد بداية الثورة بسنة واحدة، وعدل فيه بعض مواد دستور 1973، وألغى صوريا بعضا من مواده، وأضاف مواد جديدة أراد منها أن يظهر المؤسسة بشكل مختلف، فقد أعطى الدستور الجديد الصادر عام 2012 رئيس الجمهورية وبحسب المادة مئة وثمانية الحق في إصدار العفو الخاص وإعادة الاعتبار، وليس العفو العام الذي إقراره من صلاحية مجلس الشعب وذلك بموجب المادة 75 من البند السابع. فشل النظام في الظهور بمظهر الدولة التي تحترم قواعدها الحقوقية حتى في إصدار مرسوم من المفروض أن يكون وثيقة تصالحية لصالح تكريس الشخصية الفرد التي خاضت سوريا حرب الإحدى عشرة سنة السابقة في سبيل الحد منها، في حين يتجاهل النظام وحتى هذه اللحظة هذا التطلع ويتوغل في تكريس الاستبداد بالدوس على وثائقه القانونية التي يصدرها لتضبط أعماله وتظهره كدولة أمام العالم
تلفزيون سوريا
————————–
فوضى إطلاق المعتقلين..النظام استعجل “العفو” والشائعات سببت التجمعات/ مصطفى محمد
عزا المتحدث السابق باسم “هيئة التفاوض” يحيى العريضي الفوضى التي تسود عمليات إطلاق سراح المعتقلين تنفيذاً لمرسوم “العفو عن الجرائم الإرهابية”، إلى تسرّع النظام السوري في إصدار القانون.
وبيّن في حديث ل”المدن”، أن النظام اضطر إلى تعجيل إخراج عشرات المعتقلين بعد الكشف من قبل صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مجزرة التضامن، التي نفذتها قوات النظام في نيسان/أبريل 2013.
وأكد أن نشر المقاطع المصورة أشعر النظام بدرجة عالية من الخطورة، سيما أن “هناك أكثر من مليوني توثيق ضده، تعادل أو تفوق هول حفرة التضامن”، مضيفاً أنه “فور الكشف عن الفيديوهات من قبل صحيفة عالمية (الغارديان) سارع النظام إلى إصدار (العفو)، حتى دون إصدار قوائم بأسماء المعتقلين المُفرج عنهم، في إطار التعامل مع هذه الفضيحة التي لا تتناسب مع خطوات تعويم الأسد”.
وكانت مصادر النظام السوري قد نفت فعلاً وجود قوائم بأسماء المعتقلين الذين سيُفرج عنهم، وقالت رئيسة “محكمة قضايا الإرهاب” القاضية زاهرة بشماني إن كل ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قوائم لا أساس له من الصحة ومحكمة قضايا الإرهاب أو وزارة العدل لم تنشر أي قوائم أو أسماء، لأنه بعد دراسة ملفات المشمولين بأحكام مرسوم العفو، ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، يتم إطلاق سراح المشمولين بشكل عاجل من دون إذاعة أي قوائم أو أسماء، وأغلب الظن أن هناك أشخاصاً أرادوا لغايات معينة نشر هذه الأسماء.
ويرى مدير موقع “صوت العاصمة” أحمد عبيد أن حالة الفوضى بدأت أساساً بآلية إطلاق سراح المعتقلين، تبعها نشر الشائعات بين الأهالي وعبر وسائل التواصل.
وأوضح عبيد في حديث ل”المدن”، أن حالة الفوضى بدأت منذ لحظة إطلاق سراح المعتقلين، حيث عمل النظام على إخراج المعتقلين من السجن إلى البوابة الرئيسية فقط، ولم يتم نقل أي معتقل إلى النقاط التي تجمع فيها الأهالي، وهو أساس الفوضى، حيث اعتمد الأهالي في نقل الأخبار على المشاهدات فقط دون السؤال عن أي تفصيل.
وأشار إلى أن النظام أخرج الدفعة الأولى من سجن صيدنايا، وعند وصول المفرج عنهم إلى ساحة صيدنايا، بدأوا بالسؤال عن المواصلات للوصول إلى مناطقهم، وأبلغوا أهالي صيدنايا بأنهم خرجوا من السجن، وهنا بدأ أهالي صيدنايا بالتواصل مع المدن والبلدات المجاورة، وإبلاغهم أن هناك دفعة من المعتقلين في الساحة، وبدأ انتشار الشائعات عن دفعات أخرى في طريقها للخروج، وكان التجمع الذي شاهدناه.
وعن التجمع البشري تحت جسر الرئيس في دمشق، قال عبيد إن جميع المعتقلين الذين وصلوا إلى جسر الرئيس خرجوا من سجن عدرا، وبالطريقة ذاتها، تم إخراجهم إلى بوابة السجن الرئيسية فقط، فقام سائق باص مبيت بنقلهم إلى جسر الرئيس، بمبادرة شخصية من السائق، وفور وصولهم بدأ الأهالي بتناقل الأخبار حول إخراج المعتقلين وبدأ الأهالي بالتجمع في المنطقة.
وبذلك، يرى عبيد أن الفوضى ليست مقصودة من جانب النظام، ولا تصب في مصلحته أيضاً، مشيراً إلى أن دمشق تشهد منذ بدء تجمع الأهالي، حالة استنفار كامل، وانتشاراً أمنياً كبيراً في محيط منطقة جسر الرئيس، مشيراً إلى مخاوف من النظام من ردود فعل من ذوي المعتقلين.
كما يرى عبيد أن لا مصلحة للنظام بإظهار هذا العدد الكبير من ذوي المعتقلين، لاسيما في دمشق التي يروج لها بأنها حاضنة رئيسية له.
في المقابل، يعتقد البعض أن الفوضى والتجمعات البشرية الهائلة تخدم دعاية النظام، بدلالة تغطية وسائل إعلام النظام للتجمعات البشرية.
وفي هذا السياق أكد عضو “لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير” المحامي ميشال شماس ل”المدن”، أن التجمعات البشرية جذبت وسائل الإعلام، وبات الحديث متركزاً عليها وعلى إطلاق سراح المعتقلين، بعيداً عن مجزرة التضامن.
—————————-

دمشق في حالة استنفار:الأمن يفضّ تجمعات ذوي المعتقلين
استنفرت دوريات أمنية تتبع لفروع مخابرات النظام السوري في شوارع أحياء العاصمة دمشق ليل الأربعاء/الخميس، عقب التجمعات التي غصّت بها منطقة جسر الرئيس في حي البرامكة وسط العاصمة دمشق، إضافة إلى تسّيير دوريات أخرى بالقرب من ساحة مدينة صيدنايا شمال العاصمة، مهددين الأهالي هناك بالاعتقال إذا واصلوا تجمعاتهم الخميس.
وقال مصدر مطلع ل “المدن”، إن فرع أمن الدولة 255 قام بنشر عربتين مخصصتيّن لمراقبة الاتصالات في منطقت البرامكة بالقرب من جسر الرئيس حيث تجمع الأهالي الذين ينتظرون ذويهم على أمل أن يفرج عنهم في سياق العفو الأخير الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأضاف المصدر أن دوريات أمنية مختلفة التّبعية جابت أحياء البرامكة والمَزة وأبو رمانة وسط العاصمة دمشق، إضافة إلى دوريات مماثلة في منطقتي كفرسوسة والمرجة، مضيفاً أن تعليمات صارمة وجهت إلى تلك الدوريات للتعامل بحزم مع أي تجمعات “مشبوهة”.
ولفت إلى أن الدوريات الأمنية وجهت تهديدات لذوي المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام الأربعاء بالاعتقال، إذا استمرت تجمعاتهم الخميس، على النحو الذي ظهرت عليه خلال اليومين الماضيين اللذين اعقبا مرسوم العفو في منطقة جسر الرئيس وسط العاصمة، وساحة مدينة صيدنايا غربها، حيث يقع السجن العسكري ذائع الصّيت، مما أدى إلى تراجع تجمعاتهم حتى انعدمت تقريباً.
وكان رئيس النظام السوري أصدر السبت، مرسوماً تشريعياً يقصي بموجبه بمنح عفو عام عن جميع “الجرائم الإرهابية” المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان/إبريل 2022.
وبموجب العفو أطلق النظام عشرات المعتقلين من سجني صيدنايا العسكري وعدرا المركزي، مما دفع بأهالي المعتقلين إلى التجمّع في الساحات القريبة من تلك السجون، على أمل أن يكون قد شُملّوا بذات المرسوم، أو للسؤال عنهم عبر صور حملوها معهم ويعرضونها على كل من معتقل حالفه الحظ بالخروج والعودة إلى الحياة مرة جديدة.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد وصل عدد اللذين أّفرج عنهم منذ لحظة صدور العفو إلى 252 معتقلاً من مختلف المحافظات. وهو رقم يكاد لا يقارن بالأعداد الموجودة داخل تلك المعتقلات، والتي تشير إلى زهاء 130 ألف معتقل منذ بدء الثورة السورية في آذار/مارس2011، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
——————————
إنتظارات وسماسرة أمام سجن صيدنايا..”كأننا من عالم آخر“
جمعت ساحات سجون النظام السوري ومعتقلاته خلال الأيام الثلاثة التي تلت صدور مرسوم العفو، حشداً من أهالي المعتقلين السورين من مختلف المحافظات السورية، بعد توارد أنباء عن إطلاق سراح عشرات المعتقلين من سجني صيدنايا العسكري وعدرا المركزي.
وأصدر رئيس النظام بشار الأسد السبت، مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة من السوريين، قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022. وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”” إن المرسوم لا يشمل الجرائم “الإرهابية” التي أدت إلى موت إنسان، ولا تؤثر على دعوى الحق الشخصي.
وروى بعض الأهالي في الساحة القريبة من سجن صيدنايا العسكري ل”المدن”، تفاصيل الانتظار والساعات الطوال التي قضوها على أمل أن تشابه نهايات المسلسلات الرمضانية السعيدة، واقعهم.
ترابط أم محمد (60 عاماً)، لليوم الثالث على التوالي في ساحة السجن على أمل أن تحمل سيارات الشرطة العسكرية، أو الباصات التي تحمل المفرج عنهم خبراً عن أولادها الأربعة، الذين اعتقلتهم مخابرات النظام في مداهمة لمنزلهم في مدينة الكسوة بريف دمشق عام 2013. وعلى الرغم من أنها أقامت خيمة عزاء لهم، بعد أن تسلمت بطاقاتهم الشخصية من مختار مدينتها، إلا أنها ما زالت تطارد الأمل.
وتقول ل “المدن”: “قضيت 48 ساعة أطارد السراب، فتارة يقولون ستخرج دفعة جديدة بعد ساعة، وتارة أخرى عند المساء، انتظر لعلي أصل إلى هدفي المنشود”. وتضيف “في الساعات ال24 الأولى خرجت بعض الدفعات، ركضت بأقصى قوتي، ولكن هناك الآلاف مثلي، يحملون صور أولادهم ومفقوديهم، ليسألوا عنهم أولئك “المساكين” الذين ينظرون إلينا وكأننا من عالم آخر”.
وبَردَ قلب أم محمد عندما تبادلت أطراف الحديث مع امرأة أخرى، من بلدة الذيابية في ريف دمشق الجنوبي، التي كانت تنتظر مثلها أولادها الستة الذين فقدتهم مع زوجها في سجون النظام، من دون أن تصل إلى طريق إليهم حتى الآن.
وأما عن ملامح وأجساد المعتقلين الذين خرجوا، فتصفهم سارة التي ذهبت بغية الحصول على خبر عن زوجها وابنها المفقودين منذ العام 2012، ب”أشباه البشر”، “لا يعرفون إلى أين هم ذاهبون؟ ومن نحن؟ وماذا نفعل هنا؟”.
وتقول سارة ل “المدن”، إن “6 من المعتقلين المفرج عنهم كانوا في أحد الباصات الذي نقلهم من داخل السجن إلى الساحة القريبة منه. وعندما وقف الباص، وتدافع الأهالي عليهم، سقط أحدهم مغشياً عليه من الخوف، وآخر قام بتغطية رأسه خوفاً على ما يبدو من ضربه، وآخر راح يفرغ من الخوف ما توافر في معدته من لقيمات تصدق عليه بها السجان خلال الساعات الأخيرة التي سبقت خروجه”.
وتؤكد في حديثها أن “البعض منهم، هم بالفعل فاقدون للذاكرة، حتى أن أحدهم لم يتعرف حتى على أهله، الذين تعرفوا إليه من صيحات الجندي المرافق للباص الذي نادى: (يلي من درعا يجي لهون”.
سماسرة ومخبرين
ولا تخلو كل مناسبة سعيدة كانت أم حزينة من السماسرة والمُخبرين، المرتبطين بالأفرع الأمنية غالباً أو ببعض الضباط داخل السجن، بغية الحصول على بعض الأموال، وكأنما لم يكفيهم ما سرقوه من جيوب أولئك طيلة تلك السنوات.
“هل لديك من يهمك أمره؟ أستطيع أن اساعدك”، هذا ما قاله أحد السماسرة لحسام (40 عاماً)، من جديدة عرطوز، الذي تجدد لديه الأمل في خروج أخيه المعتقل منذ العام 2012، بعد الحديث عن إطلاق النظام للعشرات منهم.
ويضيف حسام ل”المدن”، أن السمسار طلب منه مليون ليرة سورية، مقابل وضع اسم أخيه في قائمة المُفرج عنهم في العفو، مشيراً إلى أن “هذه الحادثة ليست فردية، وإنما جميع من هنا يتعرضون لمحاولة الاحتيال ذاتها”، مؤكداً في الوقت ذاته أن السماسرة هؤلاء يتبعون للأجهزة الأمنية بسبب صولاتهم وجولاتهم العلنية بين مخبري أفرع الأمن الذي ينتشرون بين الناس لمنع التصوير، وخروج الصور لتجمهر الأهالي من تلك المنطقة للإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت “الحملة الدولية لإنقاذ المعتقلين السوريين” ذوي المعتقلين من عمليات ابتزاز يقوم بها “نصابون” بحجة أنهم يساعدون بزج اسم معتقل بالعفو مقابل مبلغ من المال، مؤكدة في بيان لها أن “لوائح العفو واضحة والأسماء قد حددها النظام من قبل”.
ولا توجد حصيلة نهائية موثقة للذين خرجوا من تلك المعتقلات حتى اللحظة. في حين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق خروج 150 معتقلاً خلال الساعات 48 الأخيرة التي تلت صدور العفو 150، من مختلف المحافظات السورية، موضحاً أن عملية الإفراج من المفترض أن تستمر حتى حزيران/يونيو.
————————–
مئات يتجمعون في دمشق بانتظار وصول سجناء يشملهم العفو الرئاسي
أرقام خجولة حتى الآن للمفرج عنهم
يتابع مئات من أهالي معتقلين في السجون السورية باهتمام شديد عملية تنفيذ مرسوم العفو عن «الجرائم الإرهابية» الذي أصدرته الرئاسة، وسط مخاوف من أن يكون بعض السجناء تعرض لـ«التصفية»؛ كون المرسوم استثنى «الجرائم» التي «أفضت إلى موت إنسان»، وهي عبارة يخشى معارضون أنها ربما تشير إلى «إعدام» سجناء وُجّهت لهم هذه التهمة.
ومنذ بدء تنفيذ مرسوم العفو، الأحد الماضي، تشهد منطقة «جسر الرئيس» وسط العاصمة دمشق وساحة مدينة صيدنايا وضاحية عدرا بريف دمشق الشمالي، تجمعات كبيرة لذوي المعتقلين على أمل أن يكونوا ما زالوا على قيد الحياة بعد تغييبهم في السجون والمعتقلات منذ سنوات. إذ يتم نقل المفرَج عنهم في حافلات إلى تلك المناطق وتركهم هناك دون مال يمكّنهم من العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية.
وتحدثت مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط» عن قيام سائقي سيارات عامة (تاكسي) وخاصة سيارات السرفيس الصغيرة (14 راكباً) بنقل بعض المفرَج عنهم إلى أحيائهم دون مقابل. وتساءلت «أين سيذهب المفرَج عنهم ممن لم يبق أحد من ذويهم في مناطق سيطرة النظام؟».
كما نشرت صفحات على موقع «فيسبوك» صوراً لحشود من أهالي المعتقلين وهي متجمعة تحت «جسر الرئيس» بانتظار ذويهم المفرج عنهم. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن قسماً كبيراً ممن تم الإفراج عنهم خرجوا فاقدين ذاكرتهم.
وفي الوقت ذاته، يواصل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر قوائم بأسماء معتقلين تم الإفراج عنهم من السجون بما في ذلك سجن صيدنايا سيئ السمعة، في حين وثّق «المرصد السوري» إفراج الأجهزة الأمنية، حتى يوم الاثنين الماضي، عن 240 معتقلاً من مختلف المحافظات السورية، مشيراً إلى أن عمليات الإفراج ستستمر حتى يونيو (حزيران) المقبل. من جهتها، ذكرت وزارة العدل السورية التي تتولى تنفيذ المرسوم، أنه تم خلال اليومين الماضيين إطلاق سراح مئات السجناء، وأكدت أن جميع السجناء المشمولين بالعفو سيتم إطلاقهم تباعاً خلال الأيام المقبلة.
ووصف نشطاء حقوقيون أعداد من تم الإفراج عنهم حتى الآن بأنها «قليلة جداً»، وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، «منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من 11 عاماً، تم اعتقال عشرات الآلاف وهم قابعون في السجون، وبالتالي فإن من تم الإفراج عنه يكاد يكون رقما لا يُذكر».
وفي هذا الإطار، ذكر «المرصد السوري»، أن الأجهزة الأمنية أخبرت «أعضاء الفرق الحزبية» التابعة لحزب «البعث» الحاكم ضمن مناطق سيطرتها، أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال الساعات المقبلة. ولفت إلى أنه بموجب مرسوم العفو «من المفترض أن نشهد الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين القابعين في سجون النظام».
وقال والد أحد المعتقلين لـ«الشرق الأوسط»، إن ابنه لم يتم الإفراج عنه بعد. وأوضح «اعتقلوه في 2012 لأنه شارك في مظاهرات، وكل ما نعرف أنه في سجن صيدنايا وآخر معلومة تلقيناها كانت في 2015 أنه كان ما زال حيّاً حينها». وتابع «أعيش أنا وأمه على أمل أن نراه حياً، ولكن سألنا عدداً ممن خرجوا حالياً، لكن لم يعرف أحد عنه شيئاً… الخوف أنهم قتلوه».
وقالت أم ماهر لوكالة الصحافة الفرنسية بينما كانت في عداد الحشد قرب «جسر الرئيس»، «أنتظر أولادي الخمسة وزوجي منذ العام 2014. لقد سلمتهم إلى ربي». وأضافت بحرقة «ستة أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل. نحن لا علاقة لنا بالإرهاب، عمر أكبرهم 25 سنة وأصغرهم 15».
وعلى غرار أم ماهر، تتلهّف «أم عبدو» لرؤية ابنيها اللذين لا تعلم شيئاً عن مصيرهما منذ اختفائهما في العام 2013 إثر توجههما إلى عملهما. وأوضحت للوكالة الفرنسية بينما كانت تنتظر مع جارتها «آمل أن يعودا، لم نتسبب بأذية لأحد طيلة حياتنا».
وتابعت مع ابتسامة تعلو ثغرها «قلت لجارتي: أمسكيني إذا رأيتِهما، قد أفقد الوعي. لا أعرف إذا ما كنت سأتعرّف إليهما أم لا».
وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر في 30 أبريل (نيسان) الماضي المرسوم التشريعي الرقم 7 «بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته».
وقال خبراء بالمصطلحات التي يوردها النظام في مثل هذه المراسيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض من وجهت لهم تهمة «جريمة إرهابية أفضت إلى موت إنسان»، والتي استثناهم المرسوم من العفو، «ربما جرى إعدامهم».
وقال مدير «المركز السوري للعدالة والمساءلة» محمد العبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية «هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يخرج فيها سجناء من سجن صيدنايا». وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن سجن صيدنايا كان «جزاراً بشرياً»، حيث أعدمت السلطات ما يقدر بنحو 13 ألف شخص شنقاً خلال أربع سنوات.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن العفو الرئاسي صدر بعد نشر صحيفة «الغارديان» البريطانية ومعهد «نيولاينز» الأسبوع الماضي مقاطع فيديو مروعة تعود لعام 2013 تظهر تصفية عشرات الأشخاص على أيدي عناصر من القوات الحكومية في حي التضامن في دمشق.
وتعد قضية المعتقلين والمفقودين من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيداً. وقد تسبب النزاع منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
——————————–
======================
تحديث 09 أيار 2022
————————–
مجزرة «التضامن» والمثقف العطّار/ صبحي حديدي
كشفت الانتفاضة السورية، آذار (مارس) 2011، الكثير من سوءات المثقف السوري؛ أي سلسلة الأفعال والأقوال التي تندرج في أبواب الخيانة والانتهاز والتضليل والتواطؤ والتستر والعمالة، وغيرها كثير متعدد متشعب. وإذْ تبدأ هذه السطور من صاحب العلاقة، النموذج السوري، فلأنّ الإنصاف يقتضي الابتداء من أهل البيت أنفسهم، وليس البتة على أساس المبدأ القائل بأنّ أهل مكة أدرى بشعابها، لأنّ «الشعاب» هنا أشدّ جلاءً وبروزاً ورسوخاً من أن تخطئها أيّ عين غير متعامية. والتشوّهات، كي تستقرّ هذه السطور على توصيف الحدّ الأدنى، لحقت بالمثقف السوري على خلفية الانتفاضة، لكنها تواصلت وتكاثرت وتعاظمت؛ كلما اتضح جانب مشرق أو مظلم في سيرورة تلك الانتفاضة، وكلما اختلطت مأساة بمهزلة (في صفّ مدّعي تمثيل «المعارضة»، تحديداً)، وكلما اتضح جانب مضيء وصانع أمل في حياة السوريين أو افتُضحت مجزرة وجريمة حرب…
شاعر سوري (واجتناب الأسماء، هنا، ليس له من دافع آخر سوى التشديد على النموذج التمثيلي النمطي وليس الشخص الفرد المنفرد)، تباكى على الحرية والعذاب الإنساني والشقاء اليسوعي طوال سنوات وسنوات، ومجموعة شعرية إثر أخرى؛ لكنه أعلن اللجوء إلى مسدس كلما ذُكر له مثقف منحاز للانتفاضة، ونعى الديمقراطية بعد أن أشبعها قدحاً وذمّاً. القلّة التي لم يفاجئها موقفه هذا تذكرت أنه امتدح وجود النظام السوري العسكري في لبنان، واعتبر خروجه/ إخراجه بمثابة مهانة للكرامة الوطنية السورية؛ كما استذكرت أنه امتدح التدخّل العسكري الروسي لصالح النظام، بل أطرى شخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحثّه على اعتماد قاعدة «إضربْ، لا ترحم أعداءك». القلّة إياها وجدت ما يشفع لغياب الدهشة إزاء مواقف كهذه أنّ الشاعر ذاته توجّه بالمناشدة التالية للجيش الروسي في أوكرانيا: إذا كان الإمبرياليون يتهمونكم بارتكاب المجازر، فخير لكم أن… ترتكبوا المزيد منها!
مأساوي، في جانب آخر من المشهد البائس، أن تلك التشوهات انقلبت إلى ما يشبه قواسم مشتركة تجمع شرائح واسعة من مثقفي العرب؛ من المحيط الهادر حتى الخليج الثائر، طبقاً للشعار الشهير الذي ساد خلال خمسينيات وستينيات القرن المنصرم، ثمّ باد كما يليق به وبطراز العقوبة التي ينزلها التاريخ بنماذجه. وقد يحزن المرء إزاء «ممانع» من لبنان، أو «عمّالي» من تونس، أو «نسوية» من الأردن، أو «ناصري» من مصر، أو «بوتفليقيّ» من الجزائر… يقف في صفّ النظام السوري؛ متعامياً عن كلّ مجزرة بدم بارد أو ببرميل متفجر أو بقذيفة كيميائية، بذريعة أنّ النظام «ممانع» و»مقاوم» و»أنتي إمبرالية». لكنّ الحزن إياه ينقلب إلى خيبة أمل وإحباط وفجيعة حين ينخرط في صفّ النظام هذا النموذج «اليساري» أو ذاك «الإسلامي» من أبناء فلسطين، تحت الذريعة ذاتها؛ التي تتجاسر على وقاحة نسيان جرائم آل الأسد في تل الزعتر ومخيم اليرموك.
شاعر فلسطيني (إذْ من اللافت أنهم، غالباً، شعراء!)، طليعي يكتب قصيدة النثر ولا يعجبه عجب، أقام الدنيا ولم يقعدها (محقاً، بالطبع، فهذا أمر آخر) لأنّ أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية اعتقلته بضع ساعات من داخل اعتصام في إحدى ساحات رام الله؛ يساري المحتد، لكنه اليوم مفتون بشخصية يحيى السنوار البطولية، مبتدئاً من مستوى خطابات الأخير التي ترعب دولة الاحتلال. لا يلوح أنّ الشاعر إياه قد سمع بمجزرة حي التضامن، أو بلغه واحد على الأقل من تفاصيلها الرهيبة يفيد بوجود فلسطينيين من مخيم اليرموك ضمن الضحايا؛ بحيث يبدي الأسف مثلاً، وليس الاستنكار أو الإدانة، لأنّ النظام «المقاوِم» الذي يشبّح له منذ 11 سنة ارتكب تلك الجريمة الوحشية البربرية النكراء.
شاعرنا السوري وشاعرنا الفلسطيني، وأشباههما في طول العالم العربي وعرضه، هما أوضح النماذج على حال قديمة، لكنها دائبة التجدد والتحديث، تختصر التنازل الطوعي (الانتهازي بالضرورة) عن واجب التمثيل بوصفه أحد أبرز مسؤوليات المثقف؛ والتحلل من عبء الالتزام بصوت مميز، يسهل ضبطه متلبساً بهذه «الجناية» الفكرية – السياسية أو تلك؛ وتسطيح الموقف بوسيلة تفتيته الى عشرات «الاجتهادات»، المشروطة بخضوعها جميعاً للدرجة صفر من التجانس الفكري والوضوح الأخلاقي. كلا الشاعرَين «عطّار» لا يبيع سوى أرباع الحقائق في هذه الضيعة – المنبر، وأنصاف الحقائق في تلك البلدة – المؤسسة؛ ولكنها في النموذجين ليست الأرباع والأنصاف المرشحة لتأسيس حقيقة واحدة من جهة، أو لتعريض العطار إلى أي مساءلة في حلّه وترحاله بين القرى والبلدات من جهة ثانية.
الحال ذاتها تفرّخ نسقاً من تمويه العطارة بحيث تبدو الخيانة مظهراً مشرّفاً للتغريد خارج السرب والانشقاق والرفض والاحتجاج؛ خاصة وأنّ الخيانة هنا ليست من طراز «شبه قسري» اعتبر ميشيل فوكو أنّ المثقف يمارسه وهو يرابط وسط شبكة معقدة من السلطات والأنظمة والقوى. إنها، في مثال شاعريَنا بصفة خاصة، «شطارة» التخفي اثناء الاصطفاف المكين على هامش قطبَيْ العزلة والانحياز، بدل انتزاع موقف نقدي وسيط بينهما، جدير بالمثقف الذي لا يليق به أن يكون واحداً من اثنين: صانع إجماع كاذب، أو بائع كليشيهات وحقائق مسبقة الصنع، حسب تعبير ادوارد سعيد.
وليس عجيباً أنّ العطّار، لغةً، ليس بائع العطر فقط، بل كذلك حوّاج التوابل، والتاجر المتاجر في كلّ ما هبّ ودبّ!
القدس العربي
———————————-
الشهداء المختلف عليهم/ حسام جزماتي
ترك سوريو الثورة للنظام، في ما تركوا، عيد الشهداء الرسمي في 6 أيار. وأحد أسباب ذلك، فضلاً عن رغبتهم في هجر كل رموز دولة الأسد، أن شهداءهم ما زالوا طازجين لا يحتاجون إلى عيد. فهم أحياء في فيديو مجزرة حي التضامن التي هزّت الوجدان لمن استطاع إليه سبيلا، وفي عشرات آلاف الصور العتيقة التي أشهرَها أهل قلقون في وجه بضع مئات من الخارجين الكليلين من سجون النظام إثر العفو الأخير.
اللافت في هذين الحدثين المتعاقبين هو أنهما استطاعا اختراق الجدار بين ضفتي البلاد، فتمددا من محضنهما المعارض إلى جمهور الموالاة الذي تناقل فيديو المجزرة أو صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشاهد تجمع أهالي المعتقلين والمفقودين تحت جسر الرئيس وسط العاصمة عبر وسائل الإعلام المحلية التي سُمِح لها بالتغطية لسبب ما.
لم يكن عبور الحدثين سهلاً بعد أن أصبح لكل ضفة من السوريتين أخبارها المختلفة عن الأخرى إلى حد بعيد، وانحسر التزامن. ولذلك فهما يصلحان لسبر التباين في القراءة والهوة في الموقف. فما يفترض جمهور الثورة أنه أدلة تفقأ العين لا مجال إلا أن تبعث الموالين على الخجل والمراجعة، يبدو، على المقلب الآخر، مسألة فيها نظر، قابلة لتبادل الحجج والردود ثم التملص. ويحيل هذا إلى درجة التباعد التي أزمنت وتكلست بين الفريقين اللذين أصبحا، بالفعل، طرفي حرب أهلية تنطلق من الجبهات لتشمل العقل والمحاكمة والرؤية وسياق الأدلة وتنظيم الأولويات وفق طلاقيّة النظر.
المؤيدون اللفظيون، البعيدون عن ساحة الفعل بنسبة أو بأخرى، كانوا أميل إلى تكذيب المقاطع المسرّبة والزعم أنها مفبركة
الموقف من مجزرة حي التضامن، على أطراف دمشق، بديهي لدى جمهور الثورة والعالم الغربي الغاردياني. فلا شيء أصرح في الجريمة من ارتكابها جماعياً، ولأسباب مزاجية، وخارج نطاق أي قانون، وبدم بارد. لكن الضفة الموالية للنظام تلقتها بطريقة تستحق الرصد. فالمؤيدون اللفظيون، البعيدون عن ساحة الفعل بنسبة أو بأخرى، كانوا أميل إلى تكذيب المقاطع المسرّبة والزعم أنها مفبركة. في حين سلّم بها ضمنياً من قاتلوا في صف النظام، أو القريبون من المقاتلين، ممن يشبهون مرتكبي المجزرة وربما مارسوا مثلها أو شهدوا حدوثه. لكن هؤلاء بادروا إلى التشويش على المجزرة بالتذكير بمجازر مضادة، في الساحل أو عدرا العمالية مثلاً، للقول بأن هذا من مقتضيات «الحرب»، وإن من يتحمل مسؤوليته هو من أطلقها مع بداية الاحتجاجات بعد أن كانت البلد مستقرة قبل آذار 2011. والحرب تدفع البشر إلى تجاوز طبيعتهم السوية باتجاه الغرائز، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن المنفذ الأبرز للمجزرة كان في حالة ردة فعل على فقد أخيه «الشهيد» في داريا. وهذا أمر يتفهمه مقاتلو النظام جيداً، فقد كتبوه مراراً على صواريخ وجّهت إلى المناطق المحررة انتقاماً لمقتل قريب أو ثأراً لصديق. ومن المألوف بينهم كذلك أن عدد الضحايا لا يبرّد الغليل، منذ شاعت لديهم الروح العدوانية المتغطرسة التي تعبّر عنها عبارة «بشسع نعل كليب» التي اشتهرت من مسلسل «الزير سالم» المحلي، لتفاضل بين قتيل ذي دم أزرق وبين هوامّ من قتلى الطرف الآخر هم أشبه بالذباب الذي لا يُجزئ قتله العديد مكان الفقيد العتيد!
الحادثة الثانية مركّبة من مرسوم العفو ومن الإجراءات المنفذة له.
وفي حين استبشر جمهور الثورة، أهل المعتقلين، بالمرسوم الذي بدا شاملاً، وهم الباحثون عن قشة في الأصل؛ أظهر جمهور النظام تململاً معتاداً من إخراج «الإرهابيين»، كما يفترضون بعقلية «لو ما عامل شي ما أخدوه»، وتداولوا عبارة «الرحمة للشهداء الأطهار وألف مبروك لقاتليهم». وبالكاد استطاع جمهور لصيق من المؤمنين الثابتين بـ«حكمة السيد الرئيس»، مدعوماً بهيبة الأخير وأجهزة أمنه، ضبط الأمور حتى لا تناله شخصياً تحت طائلة «طيبة القلب» التي اعتادت حاضنته اتهامه بها في مناسبات كهذه.
أما المشاهد التي صاحبت الإفراجات المخيبة، من خروج بعض السجناء فاقدين لعقولهم أو بأجساد شبحية، ومن رميهم إلى الشارع دون قوائم معلنة في حين كان أهاليهم يلاحقون كلّ باص يُفترَض أن يحملهم، ويبيتون الليل أمام سجن صيدنايا أو تحت الجسر، والتي أثارت غضب جمهور الثورة إذ رأى فيها إذلالاً إضافياً؛ فلم تحرّك في عموم الجمهور الموالي إلا الشماتة واستذكار مشاهد «مشابهة» من خيبة عائلات مفقودي النظام حين خرجت الباصات التي من المفترض أن تحملهم من دوما والغوطة، وكان عددها قليلاً بالقياس إلى المنتظر والشائعات التي سبقتها. فعاد كثير من الأهالي خائبين، كما سجلت صور ذائعة جرت استعادتها الآن.
لا جسور بين السوريتين وسكانهما الأشداء. ولا اتفاق حتى على احترام دموع وآلام الأمهات والزوجات والأطفال الذين لا ذنب لهم في ما قد يكون فعله الرجال البالغون. لا حل في الأفق. «لا تصالح! ولو قيل رأس برأس، أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟!» كما تردد القصيدة الشهيرة لأمل دنقل، المبنيّة على لازمة «لا تصالح» التي قيل إن كليباً نفسه كتبها بدمه لأخيه الزير قبل أن يفقد الحياة، في حرب البسوس أيضاً.
وحده يوسف العظمة، الواقف تمثالاً في ساحة المحافظة بدمشق، والتي تُعرف باسمه أحياناً؛ يحظى بلقب الشهيد على الضفتين دون خلاف. لكن أكثر من قرن مضى على سقوط وزير الدفاع الجسور للدولة الوليدة التي تتصارع أحشاؤها اليوم على تصنيف الشهيد في عيده الوطني.
تلفزيون سوريا
——————————–
سوريا الحقيقية تحت جسر الرئيس/ صبا مدور
يبدو مفزعا مرآى من يبحث عن امل وهو يعرف أنه مستحيل. تراه يتشبث بوهم، أو يتعلق بخيط رجاء، رغم علمه أنه سينقطع، ومعه سيقطع شريان آخر من روحه التائهة.
كل من احتشدوا تحت “جسر الرئيس” في دمشق كانوا كذلك.. رجال ونساء، شباب وكبار سن، ينتظرون سراب أبنائهم وآبائهم واخوانهم المعتقلين أو المختفين قسرا منذ سنوات، دون أن يعرفوا حتى إن كانوا أحياء أم أمواتا. كان كل واحد من أولئك السوريين اليائسين، ينتظر أن يطل عليهم وجه فقيده، وبعدما فقد معظمهم الأمل عادوا ليحزنوا من جديد كما فعلوا في أول أيام الفَقد، وكأن “عفو الرئيس” كان مقصودا لتذكير من حاول منهم التناسي أن يستعيد حزنه، فليس مقدرا لأحد في سوريا أن يعيش دون حزن، والمهم أن يكون حزنا مصحوبا باليأس، فهذان هما الوصفة الناجعة لاستلاب الناس أرواحهم، وحكمهم كقطيع بلا ملامح ولا فرصة ولا أمل.
في ذلك اليوم خلال عيد الفطر خرج عشرات السجناء من سجن صيدنايا من بين عدد غير محدد من المعتقلين والمختفين قسريا في سوريا، يقدر عددهم بنحو نصف مليون منهم 132 ألف شخص موثّقين بالاسم، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
تصف منظمات حقوق الانسان الدولية سجن صيدنايا في ريف دمشق، بأنه مسلخ بشري، وقال رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة باولو بينيرو تعليقا على (العفو الرئاسي)، إن معظم المعتقلين في سجون الاسد أُعدموا بالفعل ودُفنوا في مقابر جماعية، فيما قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن عدد من جرى توثيق مقتله تحت التعذيب في السجون السورية يصل إلى نحو 50 ألف شخص، من بين أكثر من 105 التف فارقوا الحياة خلال اعتقالهم، باستثناء الذين جرى اعدامهم.
هذه الأرقام تجعل من كل معتقل سوري مشروع قتيل، ومع انعدام تواصل السجناء مع أهاليهم لسنوات، ومع الإخفاء الحكومي الكامل لأية معلومة عنهم، لا يعود الأمل بنجاة السجناء وعودتهم للحياة مطروحا، وسيكون أفضل ما يحصل عليه ذووهم أن يعرفوا بأمر موتهم، فهم على الأقل سيكفون عن القلق على مصائرهم وعلى تخلصهم من التعذيب الذي يقتلهم كل يوم، او أنهم سيقيمون لهم العزاء ولو داخل أنفسهم، لكن حتى الموت صار عزيزا بل ورحيما في سوريا الأسد، سواء للقتيل او لذويه.
“عفو الرئيس” بعث أملا مفجعا لدى هؤلاء. أحالهم من جديد إلى سراب العدم، إلى الأمل بأن يكون من فقدوا بين المفرج عنهم، فالعفو شامل وبلا استثناءات كثير كما في كل مرة، ولكن بعد ليلة اليأس تحت الجسر، لم يخرج من صيدنايا إلا أقل من 200 سجين، غالبيتهم فقدوا ذاكرتهم أو باتوا عاجزين عن الحركة او الكلام او الادراك. الاسد افرج في واقع الأمر عن بقايا أجساد آدمية كل ميزتها أنها ما زالت تتنفس، لكن أرواحهم استلبت منهم في تلك الأقبية من سنين.
سأدعي الحياد لوهلة، واتساءل عن أي مشاعر تملكت بشار الأسد وهو يراقب صور آلاف المحتشدين تحت الجسر بانتظار ذويهم، أو وهو يتابع صور المفرج عنهم وهم بتلك الحالة: حفاة هائمون بلا إدراك ولا ملامح، هل سيحزن، أم سيغضب من الجلادين على ما فعلوا بمن يفترض أنهم شعبه، أم تراه سيندم على ما فعل، وهو يرى نماذج حقيقية هي حرفيا بعض من أفضل ممن نجا من ضحاياه؟ هل سيفعل ذلك؟
أدرك انه سؤال افتراضي عبثي إجابته معروفة، لكنه مقصود لنعيد بناء صورة سوريا التي غابت عن وسائل الإعلام والجهد السياسي أو كادت حتى جاءت مجزرة حي التضامن لتصفع بها الصامتين والمتناسين وأسرى “التغاضي” عن كل ما يثير وجع الراس ووجع الضمير، ثم جاءت مهزلة “العفو الرئاسي” لتكرر الصفعة، ولتنبه هذه المرة من نسي أو من توهم بوجود ما يسمى “سوريا المفيدة”، بأنها ليست غير وهم في العقل المريض للأسد، وفي الحقيقة، لا توجد سوريا مفيدة، بل هناك فقط سوريا الحقيقة، هي التي كان جزء منها حاضر في ذلك اليوم تحت “جسر الرئيس”.
في سوريا الحقيقية، هناك شعب تحت تراب البلاد، وشعب لاجئ يعيش خارج البلاد، وشعب نازح يعيش في مخيمات خارج دياره، في جزء من البلاد، وشعب داخل السجون- المسالخ، جميعهم مشاريع قتلى، ومن ينجو منهم، سيخرج ببقايا جسد وشبه روح، وشعب خارج السجون، يقطن داخل البلاد، يبدو للرائي أنه حر، لكنه يعيش ذليلا، مهانا، يجب ان يكون بلا كرامة ليبقى حيا.
هذا الجزء الأخير من سوريا الحقيقية هو من قضى ليلته تلك تحت “جسر الرئيس”، يمزج الأمل مع القلق والمهانة وقلة الحيلة، حتى أن التساؤل عن علاقة هؤلاء بالنظام وقبولهم أو ربما ولعهم به سيكون تساؤلا لئيما، لا منطق له، ولا داعٍ، فبعد أحد عشر عاما من الإذلال، وقبلها اكثر من 40 عاما من الاستبداد، لا يمكن ان تكون فرصة اصلا لوجود رأي بالاصل عند هؤلاء، لا يمكن ان تسأل سجينا عن رأيه في سجانه، سواء كان في الزنازين ام في بيته يخشى حتى من همس قبله أو من أجهزة تترصد أحلامه وتعاقبه عليها.
هؤلاء السوريون “في الداخل” هم ضحايا لا تقل مأساتهم عن ملايين آخرين من اللاجئين والنازحين، وكذلك عن المعتقلين والمغيبين، رأينا وجوههم في يوم احتشادهم، رأينا الرجاء اليائس والخوف والقهر، رأينا سوريا الحقيقية، التي اختفت او ربما تشوهت، بفعل الدعاية المضللة أو أخطاء المعارضة، أو الوقوع في فخ الاستقطاب والانقسام الذي نصبه النظام لنا كي يجعل منا جزر متعددة تتقاتل مع بعضها لحسابه.
أراد نظام الأسد بقرار العفو أن يسكت “شوشرة” مجزرة حي التضامن فإذا به يكشف عن جزء يسير لكنه كاف لندرك ذلك الجانب المعتم من “سوريا الحقيقية”، ذلك الجانب الذي يجعل ماساتنا أكبر من معاناة النفي والاغتراب والنزوح، فهي مأساة كل سوريا وشعبها، ولن أشرك معهم عبيد النظام وجلاديه، فهؤلاء ليسوا بآدميين وليسوا بسوريين.
المدن
——————————
حقوق الضحايا في سورية من أجل عدالة انتقالية/ سوسن جميل حسن
ما عدد السوريين الذين يفهمون معنى العدالة الانتقالية ومغزاها وضرورتها، أو يكترثون بها ويعتبرونها ضرورة يفرضها واقع الحال المزري الذي وصل إليه الشعب السوري، بعد حربٍ انتهكت كل شيء، كانوا حطبها المغمّس بالعنصرية والتعصّب وكلّ ما يهدّد الأمن والسلم المجتمعي؟ وهل يحظى الوقوف على عتبتها، كخطوة أولى في الشروع بالتأسيس لها، بالظرف المناسب؟ بل متى يكون الظرف المناسب كي يُؤسّس للبداية، من دون أن يُجهض المشروع قبل انطلاقته؟
أمام هذا السجال الذي أطلقته صحيفة الغارديان قبل أيام، بنشرها تحقيقاً مصحوباً بمشاهد صادمة عن مجزرة حيّ التضامن في دمشق، التي حصلت في شهر إبريل/ نيسان عام 2013، والتي هي واحدة من مجازر لم تكفّ عن الوقوع بحق الشعب السوري، ولم توفّر الأطراف الضالعة في الحرب القيام بها، لكنّ الأبشع من بينها تلك التي تمارسها الدولة، متمثلة بنظامها السياسي، ضدّ الشعب، أمام هذا السجال، يعود السؤال عن العدالة الانتقالية إلى الوعي، ذلك لأنّ ما يلمسه المتابع، أنّ الشعب السوري ما زال، على الرغم من كل الانهيارات التي وقعت وتقع باستمرار، محكوماً بآليات التفكير ذاتها في غالبيته، بدلاً من أن تدفعه الأزمة الجبّارة التي حلّت بحياته إلى إعادة التفكير في ما حدث، ونبش الماضي، القريب وذاك البعيد، للبحث فيه وسؤاله، للتصالح معه ووضعه في مكانه الملائم من أجل الانطلاق نحو المستقبل، وأنّنا ما زلنا بعيدين عن مفهوم العدالة وقبولها ما دام هناك من يصفقون للقتل أو يبرّرونه أو يشمتون بالضحية.
في سورية، على مدى سنوات الحرب التي بدأت بانتفاضة الشعب من أجل كرامته وحرّيته، هناك من قُتلوا بوحشية، ومن عُذّبوا، واختفوا وغُيّبوا، هناك من تعرّضوا للعنف الجنسي أو العنف القائم على النّوع الاجتماعي، وهناك من هجّوا مذعورينَ من منازلهم، واقتُلعوا من بيوتهم وماضيهم وأحلامهم، بل هناك جماعاتٌ تعرّضت للعنف والتنكيل والقتل وحرمانها حقوقها، في كل المناطق السورية، بسببِ إثنيّتها أو عرقها أو دينها أو نوعها الاجتماعي أو انتمائها السياسي. وجرى تفتيت المجتمع، غير المتماسك في الأساس، وتوزيعه على مناطق جغرافية بتغيير ديموغرافي واضح يتبع أجندات صاغتها كلّ الأطراف الضالعة في النزاع.
صحيحٌ أن مفهوم العدالة الانتقالية حديث، ويلزمه حدّ ما من الوعي والاهتمام، ويُعدّ من شواغل النخب المجتمعية في المجالات التي لها علاقة به، لكنّ مفهوم العدل والعدالة بشكلهما الأولي من القيم التي تتباهى المجتمعات بها، وهذا مطلب على الصعيدين، الشخصي والعام، فهل من الصعب نشر الوعي بمفهوم العدالة الانتقالية؟
تعني كلمة انتقالية أنّ المجتمع ينتقل من مرحلة إلى أخرى. وفي الواقع، لم ينتقل المجتمع السوري (أو المجتمعات السورية؟) من مرحلة إلى أخرى، بل ما زال تحت سلطة الظروف نفسها، والآليات التي تحكمه نفسها، في كلّ المناطق، فيما المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام تخضع لأنظمة حكم وإدارة تشبه ما يمارسه النظام، وكأنما هناك توأمة لتلك السلطات بعضها مع بعض، فكيف يمكن وضع أهداف والشروع بها من أجل مساعدة المجتمع في الانتقالِ من النزاع إلى السّلام المُستدام، ومن الحكم الاستبدادي إلى الدّيمقراطيّة؟ للمجتمع السوري خصوصيته بالغة التعقيد، التي أظهرت الحرب تمكّن عقدها من نسيجه، ذلكَ أن ثقافته وتاريخه وبُنيانه القانونيّ والسّياسي وتعدّده الإثنيّ والديني والطائفي وتكوينه الاجتماعي والاقتصادي، كلّها لم تشتغل الأنظمة، الاجتماعية أو السياسية أو الدينية، على تنقيتها وتطويرها وشلّ قدرتها على التأثير الشديد في حياة الأفراد والجماعات، بل ترك المجتمع لاستنقاعه المديد، وزادت الحرب التي استُثمر فيها بالطائفية والإثنية في جعل المسافة تطول أكثر بين السوريين وبين مجتمعٍ أكثر سلاماً وعدلاً وشمولًا للجميع، مجتمع مأمول في أن يكون قد قطع شوطاً كبيراً في تصفية حساباته مع الماضي، بكلّ حمولاته العنفية والتقسيمية والإقصائية، قادر على إنصاف ضحاياه من كل الأطراف. وفي الواقع، ما زلنا بعيدين مسافاتٍ شاقةٍ عن تصفية حساباتنا مع الماضي البعيد، ماضٍ عمره قرون من الحروب والاقتتال والظلم والمظلومية المبنية على سردياتٍ تاريخيةٍ عملت على تطويع التاريخ، ليخدم أهدافها ويزيد من التفاف جماعاتها وتراصّهم في كتلٍ صلدة، ماضٍ بمثابة منارة وحيدة لمستقبل مضمر في نفوس الجماعات، فكيف يمكن التصالح مع ماضٍ قريب هو جزء من ذاك البعيد؟
لم تفعل الحرب، وكذا ضنك العيش الذي يعيشه السوريون اليوم، إنْ في الداخل وفي مناطقه الموزّعة على سلطات أمر واقع، بالإضافة إلى مناطق النظام، إلى السوريين في المخيمات في دول الجوار، حيث يتراجعون أيضاً في مستويي العيش والتطور، إلى السوريين في دول اللجوء البعيدة، في جعل غالبية السوريين يتراجعون قليلاً عن متاريسهم، ويفكّرون في سنوات الجمر وذاكرة الدم التي تنهض من جديد، مع كلّ خبرٍ أو مجزرة، بل يستعيدون الهمم في شحذ نفوسهم والتمترس خلف المقولات المضلّلة، عن الأحقية والظلم، والاستهداف والقتل، إذ يسعى كلّ فريقٍ لتخوين الآخر وتحميله مسؤولية الخراب، واتهامه بمحاولة قتله وإقصائه عن الوطن وأحقية العيش فيه. وهذا ما شاهدناه بعد فضيحة مجزرة التضامن، التي لا تحتمل أي موقفٍ سياسي أو غير سياسي، بل ما تحتاج إليه موقف أخلاقي إنساني، إذ كيف لأحدٍ أن يصفّق للقتل بهذه الطريقة؟ وتشير هذه الظاهرة إلى معضلة كبيرة ومعقدة، إذ تشكّل حجر عثرة راسخ أمام تعزيز مفهوم العدالة الانتقالية، فيما لو حلم الشعب بمرحلةٍ انتقالية تجعله يتجاوز عنق الزجاجة المحشور فيه منذ بداية الحرب.
ما زلنا بعيدين عن مواجهة الأسئلة الصعبة التي يبدو كما لو أنّ المعنيين يشيحون وجوههم عنها، أسئلة البداية، الخطوة الأولى، كيف ومتى؟ وما بعد الخطوة الأولى، فيما يضمن الاقتراب من مستقبلٍ يضمن السلام المستدام وإمكانية تحقيق مجتمع شامل لكل أبنائه، مجتمع قادر على التخلّص من حمولات الماضي، وهذا لن يحدث من دون تحقيق العدالة الانتقالية، ونصرة الضحايا من كل الأطراف، ثم إصلاح القوانين وضمان نزاهتها، واعتراف المرتكب بجريمته، وخضوعه للقانون، ثم الدخول في مرحلة تعزيز القيم العليا بعدها، كالتسامح بين مكونات المجتمع. أمّا الغفران فأمر شخصي بالمطلق، ولا يمكن طلبه أو فرضه.
العدالة الانتقالية يلزمها جدول زمني، ويلزمها تعاقدٌ مع الوقت، إذ لا يمكن تجاوز مراحل في تدرّج تطبيقها، لأن عقبات كبيرة وراسخة في طريقها، لكن لا بدّ من تقريب مفهومها إلى أذهان الناس وضمائرهم، خصوصاً الذين ما زالوا مؤمنين بأن الحكومة هي الضامن لحياتهم، وهي التي تواجه تآمر العالم عليها، ولا بدّ أن سلوكها في الحرب سليم يسعى لحماية الشعب والوطن، بالرغم من كل البراهين على خراب الشعب والوطن، وبذلك يبرّرون القتل، وقد يمارسونه، إذا اقتضى الأمر من منظورهم هذا.
هناك محاولات جادّة من سوريين يجتمعون على أهدافٍ تصبّ في مصلحة الشعب والمستقبل، وهناك مجموعات مجتمع مدني في الواقع وفي الفضاءات الرقمية، وهناك أفرادٌ لا ينتمون إلى أي حزب أو حركة سياسية أو مؤسسة مدنية، لكنهم يعملون بشكل مستقل على نشر الوعي بين الناس، وهناك منظمات حقوقية ومدافعة عن حق الضحايا من كل الأطراف، لكن هناك لمسة مفقودة، وهي أساسية من أجل دفع المشاريع التنويرية التي لا بدّ منها كأساس لتمكين الحياة المستقبلية، لمسة قد يلتقطها اجتماع هذه المجموعات بعضها مع بعض، فيكون تأثيرُها أوسع وأكثر قدرة على إحداث الفارق في الوعي العام الذي ما زال بعيداً جدّاً عن قبول فكرة العدالة الانتقالية القائمة أساساً على حماية حقوق الضحايا واحترامها، وهذه الحماية هي الحجر الأساس في العيش المشترك وبناء المستقبل في سورية.
العربي الجديد
—————————–
“اعتقلوني يومين وقال رجعتْ لحضن الوطن”… العودة المزيّفة للمعتقلين السوريين/ كارمن كريم
الصور تشي بمكر النظام عن طريق إحضار معتقلين بصحة جيدة إلى حد ما عكس المعتقلين الذين أطلق سراحهم سابقاً والذين بدا عليهم الإرهاق والضعف الشديد، إلا أن النظام وقع في خطأ جديد وهو أن بعض المعتقلين كانوا مراهقين وهكذا أثبت، من دون قصد ربما، أنه يعتقل الأطفال ويعذبهم في سجونه.
للسوريين ذكريات مع جسر الرئيس، ولنقل تحت جسر الرئيس تحديداً، والذي يقع في قلب العاصمة دمشق قريباً من فندق الـ”فورسيزون”، ليس غريباً أن يكون واحداً من أكثر الأماكن بؤساً على الرغم من اسمه: “جسر الرئيس حافظ الأسد”.
المكان هو عبارة عن كاراج باصات وميكروباصات تنطلق نحو عدد من المناطق الواقعة على أطراف العاصمة دمشق، كقدسيا وضاحية الأسد ودمر البلد، كما يمر من هناك النقل الداخلي المتجه نحو باب توما أو المزة. في اختصار هي منطقة تعجّ بالبؤس والانتظار، تنتشر فيها بسطات المأكولات الرخيصة ويتبول المتشردون على جدران المكان، ولم يكن انتظار عائلات المعتقلين في ذلك المكان تحديداً سوى استكمال لعلاقة السوريين الموجعة مع ذلك المكان.
طفلٌ بين المعتقلين
بعد الفوضى التي عمت وسط العاصمة بسبب عشوائية وقسوة النظام الذي لا يكترث لا بالمعتقلين ولا بعائلاتهم بحيث لا يعلن معلومات واضحة عن المعتقلين أو أسباب اعتقالهم أو متى يفرج عنهم، إذا أفرج عنهم. وبعد الضجة التي رافقت حملة الافراج الاخيرة، قامت محافظة دمشق بخطوة أقرب إلى محاولة التعتيم على هذه الفوضى من خلال تبنّي منهج مخادع يعتمد على جلب بعض المعتقلين وعائلاتهم، وسط تغطية إعلامية في مبنى المحافظة في دمشق.
الصور تشي بمكر النظام عن طريق إحضار معتقلين بصحة جيدة إلى حد ما عكس المعتقلين الذين أطلق سراحهم سابقاً والذين بدا عليهم الإرهاق والضعف الشديد، إلا أن النظام وقع في خطأ جديد وهو أن بعض المعتقلين كانوا مراهقين وهكذا أثبت، من دون قصد ربما، أنه يعتقل الأطفال ويعذبهم في سجونه.
ما يزال أخ الطبيبة رانيا العباسي، عبر صفحته على فيسبوك، يناشد معرفة مصير أخته وأبنائها وبناتها الستة، طبيبة الأسنان التي اعتقلت عام 2013 برفقة أولادها والتي كانت أصغرهم رضيعة في عمر السنة والنصف، تُرى هل اتهم النظام الرضيعة بالإرهاب؟
جلس المعتقلون بينما حركوا أيديهم يهتفون للأسد: “بالروح بالدم نفديك يا بشار” وكأنهم آلات تفعل ذلك بشكل تلقائي، كأنهم مصممون لفعل ذلك أمام الكاميرا، ستصل بعدها صورتهم لكل منزل سوري، وخصوصاً منازل عائلات المفقودين والمغيبين قسراً. من الوجوه المميزة بين المعتقلين كان طفلاً يبدو أنه لم يتجاوز السادسة عشر، ينظر مباشرة نحو الكاميرا والسؤال: ماذا يفعل هذا الطفل هناك؟ وكم سنة قضاها في السجن؟ وما التهمة التي ألصقها النظام به؟
الرجوع المزيف إلى حضن الوطن
لكن ما نحن متأكدون منه أن هؤلاء المعتقلون ألقي القبض عليهم قبل أيام، ففي حادثة مشابهة قبل أعوام، ولحماية الشهود، لن نحدّد عن أي عفو نتحدث بالتحديد، كان ثلاثة شبان يركبون سيارتهم حين أوقفهم حاجزٌ للنظام وألقى القبض على اثنين منهم، أحدهم بحجة أن هويته مكسورة. بعد يومين ظهر الشابان على التلفاز برفقة عدد من المعتقلين والذين تبدو صحتهم جيدة ضمن من شملهم العفو، بينما وقف مفتي الجمهورية يخطب بهم قائلاً إن هذه فرصة جديدة ومكرمة من الرئيس ليبدأوا حياتهم من جديد. يقول أحمد (اسم مستعار) باستغراب: “أنا هويتي مكسورة، اعتقلوني يومين وقال رجعت لحضن الوطن!”.
هذه القصة القصيرة تلخّص خداع النظام الذي لا يستطيع أن يُظهر معتقلين مضى عليهم سنوات داخل سجونه لأن هيئتهم ستفضح وحشيته ولذلك يعتمد على اعتقال شبان جدد، أو يجلب سجناء من سجون أقل وحشية من سجن صيدنايا كسجن عدرا ويظهرهم على الإعلام في محاولة للتغطية على المعتقلين الذين خرجوا في الأيام الأولى بأجساد ضعيفة ومنهكة.
النظام الماكر مازال يبدع في إدهاشنا، ليس فقط في مراوغته وكذبه إنما بقدرته على التغطية على آلام السوريين وتحويلها إلى “سعادة” أو “لحظة تاريخية”، لا حول للسوريين ولا قوة، إذ بات الانتفاض بوجه النظام شبه مستحيل في ظل تعويم النظام من قبل عدد من الدول العربية، وشتات السوريين في جميع أنحاء الأرض، في حين أن من بقوا في سورية هم قلة من المعارضين. ولا يمكن تحمل البقاء تحت حكم هكذا نظام إلا في حالة العجز المادي أو وجود فرد من العائلة في معتقلات الأسد لا تودّ العائلة تركه خلفها.
فلسطين المعتقلة داخل سجون الأسد
أفرج النظام كذلك عن خمسة معتقلين فلسطينيين، بينهم لاجئ فقد ذاكرته بسبب التعذيب، بينما لايزال هناك أكثر من 1800 معتقل فلسطيني في سجون الأسد لا توجد أي معلومات عنهم وذلك بحسب ما قالت ” مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية“. قد تكون الأعداد أكبر من العدد المعلن بسبب تخوف الأهالي من الملاحقات الأمنية وغياب أي قوائم رسمية. الفلسطينيون الذين يعانون في سجون الأسد أضعاف معاناتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم خير إثبات على تورط النظام في زيادة مأساة الفلسطينيين وليس العكس كما يدعي.
وبحسب النظام سيصار إلى تأمين وصول المفرج عنهم إلى ذويهم سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوحدات الإدارية. وإذا اتّبع النظام هذه الآلية فعلاً سيكون لأجل هدفٍ واحد: تخفيف أصداء خروج المعتقلين والصور المرعبة التي تنتشر للتائهين منهم، أي لن يكون ضمن أولوياته أهالي المعتقلين إلا إذا صبّ الأمر في مصلحته. على سبيل المثال، حتى الآن لم يتحدث النظام مع عائلات جميع من ماتوا داخل معتقلاته مؤكداً وفاتهم، يقول المحامي سامر (اسم مستعار): “على الرغم من تأكدي قبل سنوات من موت عدد من المعتقلين ونقل الخبر إلى عائلاتهم إلا أنهم وبعد العفو عاودوا الاتصال بي”. عدم منح هذه العائلات أي يقين بشأن أبنائهم هو شكل من أشكال التعذيب والإرهاب النفسي بحقهم، ليس هذا وحسب يقول سامر: “من المعروف لو ذهب الأهالي للسؤال عن أبنائهم في سجن صيدنايا وقيل لهم أنه تمّ نقلهم إلى فرع الامن العسكري فهذا يعني أنهم ماتوا لكن النظام لن يخبرهم بذلك!”، وهذا ما يتسبب في غضب الأهالي ورجوعهم إلى المحامي متهمين إياه بالكذب بعدما أخبرهم النظام بأن أبناءهم نقلو إلى مكان آخر، يقول سامر: “من الصعب إخبارهم أن النقل إلى فرع الأمن العسكري يعني موت أحبائهم”.
درج
——————————-
سوريا:تجميد ملاحقة النظام للمطلوبين..”كذبة خبيثة“
وصف معارضون سوريون إعلان وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري عن تجميدها لكافة البلاغات والإجراءات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة “الإرهاب”، بالـ”كذبة الخبيثة”.
ونشرت وزارة العدل بياناً على موقعها في “فايسبوك”، قالت فيه: “تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /٧/ لعام ٢٠٢٢ (…) فقد تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث – توقيف – مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /١٩/ لعام ٢٠١٢”.
وأضافت أن القرار يشمل جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، موضحة بالقول “ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.
ووصف عضو هيئة القانونين السوريين المحامي عبد الناصر حوشان البيان الممهور بقلم وزير العدل بـ”الكذبة الخبيثة” قائلاً: “القانون وبيان الوزير وتصريحات رئيس محكمة الإرهاب لا تعدو كونها مجرد كذبة خبيثة من أكاذيب النظام، ومحاولة من محاولاته لذرّ الرماد في العيون الأمر الذي يقتضي منا جميعا الوقوف في وجهه والتصدي لها وإفشالها وعدم التماهي معه ومع شبيحته”.
وقال حوشان لـ”المدن” إن “هذه البرقية ليست قراراً ملزماً وإنما هي بيان للإعلام فقط”، موضحاً ذلك بالقول: “إن وزير العدل يمثل السلّطة التنفيذية ولا سلطان له على إيقاف مثل هذه البرقيات”، مبيناً أن استرداد هذه المذكرات هي من صلاحيات المحاكم التي صدرت عنها.
وأضاف أن “مثل هذه البرقيات (توقيف-مراجعة-ملاحقة) موجودة في جميع الأجهزة الأمنية على اختلاف مرجعيتها، ومختلفة اختلافاً كامل عن تلك التي تصدر عن النيابة العامة”، موضحاً أن “الأولى تعد إجراءاً أمنياً، أما الثانية فتعد إجراءاً قضائياً”، مشيراً إلى أنهما متشابهان من حيث الاسم فقط.
ويستغرب حوشان البيان قائلاً: “إن وزير العدل ليس لديه صلاحية إيقاف المذكرات التي تصدرها النيابة العامة، فكيف سيكون له سلّطة على تلك البرقيات الصادرة عن الأجهزة الأمنية التي تتبع لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية؟
واشار إلى أن إلغاء مثل هذه الإجراءات “منوط بمدراء أجهزة المخابرات وفق آلية رفع مذكرات رأي للرئيس الأعلى في الجهاز وهو صاحب القرار النهائي ولا معقب على قراره أحد”.
ولفت حوشان النظر إلى السطر الأخير في البيان الذي وردت فيه عبارة “ما لم يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”، وقال إن “غياب المدة الزمنية لتسليم المطلوبين أنفسهم يعني أن حالة الجرّمية تبقى قائمة من اللحظة التالية نفاذا قانون العفو الذي أصدره رئيس النظام”.
ورأى أن “الغموض المُتعمّد وتجنّب الجهات القضائية تحديد آلية التحقق من إنهاء العلاقة بالمنظمات أو الدول، وإطلاق التصريحات والبيانات بصيغة التعميم في الوقت التي يجب تخصيصها؛ تجعل العلاقة مع أي دولة من الدول أو مع أي منظمة من المنظمات جريمة تستدعي الملاحقة والتوقيف والمحاكمة، والتي قد تكون عضوية مجلس محلي أو دفاع مدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أو عضوية موقع أو صحيفة خارج سوريا”.
ونبّه حوشان المعارضين والمطلوبين الى “ضرورة عدم الانجرار نحو تلك التصريحات الهادفة الى إيقاعهم في أخاديد مشابهة لتلك التي ظهرت في مجزرة التضامن”، داعياً الى “الاستدلال الى بيان سفارة النظام في بيروت التي اشترطت إجراء التسوية للمطلوبين قبل التوجّه نحو سوريا، الأمر الذي ينسف رواية العفو المزعومة وأكذوبة البيان الحالي”.
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد السبت الماضي، مرسوما تشريعيا يقضي بموجبه بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان/إبريل 2022، عدا عن تلك التي أدت إلى موت إنسان.
—————–
من حفرة التضامن إلى جسر الرئيس: ضبابٌ كثيفٌ يأوي إليه المجرمون والقتلة/ فوز الفارس
لا شيءَ جديد! فمنذ ما يزيد على عقدٍ من الزمن اعتاد السوريون أن يناموا على مجزرة ويستفيقوا على أخرى؛ فالعصابة المجرمة الحاكمة قد أصبحت أكثر تمرّسًا في ارتكاب المجازر، عصابة قد اختصّت بهندسة المجازر وإخراجها في أفظع صورة ممكنة، عصابة تستطيع التنقّل بسهولة من دور القاتل إلى دور المنعم المتفضّل الذي يمنّ بعفوه على الآخرين، وينظر بعين العطف إليهم من خلال عفوٍ هزيل أريد له أن يكون بمنزلة الممحاة التي يطمس من خلالها ملامح مجزرة أفلتت بالخطأ من قيوده الصارمة وأحدثت أثرًا وصدىً لم يكن بحسبانه؛ إلّا أنّ هذا العفو قد ضلّ السبيل، وارتدى لبوس المجزرة، ورفع الستار عن كواليس خفيّة لمجازر من نوعٍ آخر؛ مجازر غير مرئيّة لم تلتقطها عدسات أوشكت على الاحتراق لفرط الآلام التي التقطتها وخزّنتها.
هذا النظام المجرم يتلذّذ ببعث الأسى، بتجديد آلام السوريين بين الحين والآخر، فكلّما خبت ذكرى مجزرة قليلًا في ذاكرة السوريين المطبقة على الوجع، يبعث مجازر أخرى من مراقدها، يفتح من خلالها آلاف الجراح التي لن يندمل منها إلّا النزر اليسير، بينما جراح أخرى كثيرة ستبقى مفتوحة تنتظر اللحظة التي سيمنّ بها هذا النظام الموغل في فجوره وإجرامه بخبرٍ صغير يبردّ تلك الجراح، وهذا الديكتاتور الذي يتربّع على عرش الإجرام قد بلغت فيه السفاهة والوقاحة درجةً لا تُطاق، لا يكلّف نفسه عناء التستّر على إجرامه المنفلت من كلّ قيد، يقتل القتيل ويمشي في جنازته، يبيد المدنيين بالكيماوي في دوما ثمّ يأتي في العيد ليصلّي في أحد مساجدها، وكذلك في حمص، واليوم في مسجد قريب من حفرة التضامن، وكأنّه يسخر من السوريين ويمدّ لسانه هازئًا بآلامهم، يفتح جروحهم كلما هدأت قليلًا، ليرشّ الملح عليها، ويقول لهم: “موتوا بغيظكم! فنحن فوق آلامكم قاعدون ولن نبرحها”.
أراد النظام المجرم أن يهيل التراب على حفرة التضامن ليُخفت أثرها من خلال ما سمّاه “عفوًا”، لكنّه فتح ثغرة في جدران المقتلة السورية الكبرى، ثغرة صغيرة كانت كفيلة بهتك أستار من التعتيم السميكة التي يسدلها على ضحاياه، ثغرة ضيقة وسّعتها حشود السوريين التي تنتظر خبرًا عن حياة أحبّة لهم غيّبوا في زنازين ومعتقلات نظام متوحّش بمجرّد أن فكّروا بحياة لا وجود فيها لهذه العصابة المتحكّمة بأرواح العباد والجاثمة على صدورهم منذ ما يزيد عن نصف قرن، عصابة لم ترتوِ من دماء السوريين التي سالت مرارًا، عصابة يتلخّص وجودها واستمرارها بمزيد من دماء السوريين التي أصبحت بمنزلة النسغ الذي يسري في جسدها ولا تستقيم حياة هذا الجسد إلّا بمزيدٍ من الدماء.
هذي الحشود التي تقتصر على أهالي مدينة دمشق وبعض الوافدين من المحافظات السورية الأخرى في فترة سابقة وحاليّة، لنا أن نتخيّل فيما لو كان بوسع السوريين النازحين في الشمال وفي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وكذلك الموجودين في الشتات؛ الوصول إلى ذلك المكان والانضمام إلى الحشود، هل ستتّسع شوارع دمشق وساحاتها لهم؟
إنّ هذه الصور كفيلة بإثبات كذب النظام وإعلامه للمرّة الألف على التوالي، النظام الذي لطالما أنكر وجود الآلاف في معتقلاته، وأخفى أسماء كثيرة وحجب معرفة مصيرها، فضلًا عن أولئك الذين قضوا خلال الفترة السابقة ودفنهم بصمت في مقابر جماعية ولم يكشف عن مصيرهم، هذه الصور تثبت مجدّدًا أن ما خفي من إجرام هذه العصابة أكبر بكثير ممّا ظهر منها للعلن، وأنّ هذه العصابة المجرمة قد اعتقلت بلدًا بكامله على مرأى ومسمع من العالم كلّه، هذا ما تقوله صور الآلاف من الأهالي وهم يحتشدون تحت جسر الرئيس المتربّع على سدّة الخراب.
لقد فتح النظام بعفوه هذا نافذة أخرى للعالم ليرى من خلال تلك الجموع المحتشدة أنّه لم يبقَ بيت سوريّ لم تطله يد تلك العصابة المجرمة بالأذى، لم يبقَ بيت سوري لم يتجرّع سمّ إجرامه بالقتل والنفي والتغييب القسريّ، أراد المجرم تبييض صفحته من خلال الآمال الكاذبة التي هي أقصى ما يمكن لعصابة مجرمة أن تجود به على القلوب المكلومة لعوائل سورية فجعها بأفرادٍ منها، أو بفردٍ واحدٍ منها على الأقل.
من حفرة التضامن إلى تحت جسر الرئيس؛ تظهر سوريا أشبه ما تكون بمعتقلٍ كبير، يرزح نصف أبنائه خلف قضبان المعتقلات وفي سجون العصابة الحاكمة وزنازينها السريّة، بينما ينتظر النصف الآخر في الخارج خبرًا عن أولئك الموجودين خلف القضبان، والفئة القليلة المتبقيّة من الطغمة الفاسدة لهذه العصابة الحاكمة ينتمون إلى فئة الجلادين والسجّانين والحارسين لسوريا (المعتقل الكبير).
مواجع السوريين موضوعة دومًا في قدر النظام المجرم، يشعل النيران تحتها أو يطفئها، يضيف التوابل والبهارات، مجزرة من هنا، وأخرى هناك، صور لجثث المعتقلين سرّبتها عدسة “قيصر”، شهادة “حفّار القبور”، صور سابقة مسرّبة لجنودٍ يتسلّون في ركل الجثث ودفعها إلى حفرة وحرقها، الغاية الوحيدة من ذلك كلّه تقليب مواجع السوريين وإيقاظ الراكد من مواجعهم في سبيل حياة لم تعد عند كثيرين سوى استراحة قصيرة بين أشواط طويلة وممتدة للموت الذي بات قدر السوريين أينما ذهبوا.
هذه الحشود تكذب ادعاءاته وإحصاءاته وقوائمه، وتثبت أنّه لم تبق عائلة سورية لم ينكّل هذا النظام المجرم بها، وفي الكواليس المعتمة ما هو أدهى وأمرّ وليست مجزرة التضامن التي ارتكبها فرد من هذه العصابة بحق 41 سوريًّا سوى شاهد صغير على أنّ ما يخفيه النظام من إجرام وما أفلت من العدسات الموثّقة له سوى نقطة صغيرة في بحر إجرامه المترامي الأطراف، ذاك المشهد الذي ينتمي إلى عالم الخيال مجرّد مقطعٍ صغير مسرّب من فيلم طويل لإجرام النظام بدأ منذ العام 2011 مع انطلاق أوّل صرخة طالبت بالحرية، وهذه اللقطة وحدها كفيلة بأن تنبئك عن الحالة السورية التي لطالما كان الواقع فيها متفوّقًا على الخيال، خصوصًا أنّ المتعارف عليه في عالم الجريمة؛ حرص المجرم على طمس جريمته وإخفاء معالمها فلا يقوم بتوثيق تفاصيلها في كلّ مراحلها، فتكون شاهدًا عليه كما هو الحال في هذه المجزرة التي فتحت نفقًا واسعًا في ذاكرة السوريين عن المجازر الفظيعة التي ارتكبها النظام بحقهم طوال السنوات الماضية.
هذا النظام المجرم الذي لقّن أتباعه وأشياعه هندسة المجازر وفنّ صناعة المواجع وتقليبها، ليس لديه لذّة تعدل لذّة الفرجة على آلام السوريين المارقين ممّن استطاع أن يحيل حياتهم إلى جحيم متواصل، والفرق بين حياة سوري وآخر هو الفرق بين القاع والقمّة والأماكن الممتدة على تلك المسافة الفاصلة بينهما، وهو يتربع على عرش الجحيم والطغمة الخاصة به أمثال (أمجد يوسف) هم الحراس والجلادون وما يتسرّب من مشاهد صغيرة بين الفينة والأخرى مجرد صورة مصغّرة عن الجحيم الذي ألقي في غياهبه السوريون جميعًا.
نعم! لا شيء جديد، فمن حفرة التضامن إلى جسر الرئيس؛ ضبابٌ كثيفٌ يلفّ حياة السوريين، ومن تلافيفه ينبعث المجرمون والقتلة وهم يحملون أسلحتهم التي تفنّنت وأدمنت انتزاع حياة السوريين، من حفرة التضامن إلى جسر الرئيس؛ صورة مصغّرة استطاعت العدسات التقاطها للجحيم الأسدي، وفيها تبدو المقتلة السورية الكبرى أقرب إلى الدراما الموغلة في الوحشيّة والسادية، هكذا أراد النظام المجرم؛ منتج المجازر ومهندسها بحقّ السوريين، وهذا جزءٌ يسيرٌ من المشهد يلتقطه من في الخارج مذهولًا ولا يستطيع تصديقه، أمّا السوريون فيعلمون علم اليقين أنّ ما خفي أدهى وأمرّ وأقلّ بكثير ممّا يظهر للعلن، ففي الحالة السورية لطالما تفوّق الواقع على الخيال وسبقه بأشواط ومراحل كثيرة
——————————–
من أصل آلاف المعتقلين.. كم بلغ عدد المفرج عنهم من سجن صيدنايا بمرسوم “العفو”؟
أعلنت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، أمس الأحد، عن عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا ضمن مرسوم “العفو” الأخير الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقالت الرابطة إن عدد المعتقلين الذين خرجوا من سجن صيدنايا واستطاعت توثيقهم، بلغ حتى مساء الأحد 117 معتقلا من عدة محافظات سورية.
وذكرت في بيان على فيس بوك أنّ ست حالات من المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم إلى أشهر الثورة الأولى وتحديداً العام 2011، في حين أنّ ثماني حالات من المفرج عنهم تاريخ اعتقالهم يعود للعام 2012. و32 حالة اعتقلوا في عام 2018.
وينحدر المفرج عنهم من محافظة ريف دمشق بعدد 39 معتقلا، تليها محافظة درعا بـ 34 معتقلا، ثم حمص بـ 20 معتقلاً، ومن إدلب ثمانية معتقلين، وأربعة من القنيطرة ومثلهم من حماة وثلاثة من الحسكة، من بين آلاف المعتقلين المحتجزين في سجن صيدنايا.
ويأتي خروج الدفعات الجديدة من المعتقلين، بعد أيام من إصدار رئيس النظام في سوريا بشار الأسد ما سمي “عفوا عن الجرائم الإرهابية”.
يشار إلى أن ناشطين سوريين حذروا الأهالي من قيام حسابات موالية لنظام الأسد بنشر أسماء وصور تعود غالبيتها لأشخاص متوفين سابقاً، لعدة أهداف منها ابتزاز ذوي المعتقلين مادياً.
كما رجح بعض الناشطين أن هذا العفو المزعوم هو محاولة للتغطية على التسجيل المصور الذي نشرته الغارديان موخرا ويظهر عملية إعدام بحق 41 مدنياً على يد عناصر من قوات النظام في حي التضامن الدمشقي.
————————–
الكشف عن تلاعب بقوائم أسماء المعتقلين المفرج عنهم بـ “العفو” في سوريا
أفاد موقع “صوت العاصمة” بأن ضباط استخبارات النظام، ومسؤولين في اللجان القضائية تلاعبوا في قوائم أسماء المعتقلين المشمولين بمرسوم “العفو” الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد في شهر نيسان الماضي.
وقال الموقع نقلاً عن مصادر متعددة من أهالي وذوي المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً، إن “العفو” الصادر فتح باب الرشاوى والابتزاز لذوي المعتقلين مجدداً، موضحاً أن قيمة المبالغ المفروضة على الأهالي تختلف باختلاف تهمة المعتقل ومدة اعتقاله.
وأكد أن بعض أعضاء اللجان القضائية وموظفي الضابطات العدلية، فرضوا مبلغ يقدر بـ 100 ألف ليرة سورية على ذوي المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم “العفو الرئاسي”، لتقديم موعد إخلاء السبيل، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين المتنفذين تواصلوا مع مئات العائلات من ذوي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المعتقلين في الفروع الأمنية، وعرضوا عليهم تقديم موعد إطلاق سراح أبنائهم.
بدورها، رضخت عشرات العائلات للابتزاز دفعت المبلغ المطلوب، مقابل تقديم طلب إخلاء السبيل والحصول على القرار وإدراج أسماء ذويهم المعتقلين ضمن قوائم الإفراج الأولى.
وبحسب الموقع، فإن العديد من المعتقلين المفرج عنهم، تقدمت أسماؤهم عن غيرها بعد دفع ذويهم المبالغ المذكورة. كما أن القوائم الصادرة نصت على إطلاق سراح المعتقلين على شكل دفعات محدودة، وليس بشكل جماعي.
من جانب آخر، ذكرت مصادر الموقع أن المبالغ المفروضة على ذوي المعتقلين، (الـ 100 ألف ليرة)، شملت فقط المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم العفو في الدفعات الأولى. أما أهالي “المعتقلين القدماء” فقد طالبتهم الجهات ذاتها بدفع مبالغ طائلة وصلت إلى 2 مليون ليرة سورية لإصدار برقيات إخلاء السبيل.
ويأتي خروج الدفعات الجديدة من المعتقلين إصدار رئيس النظام في سوريا بشار الأسد ما سمي “عفوا عن الجرائم الإرهابية”.
يشار إلى أن ناشطين سوريين حذروا الأهالي من قيام حسابات موالية لنظام الأسد بنشر أسماء وصور تعود غالبيتها لأشخاص متوفين سابقاً، لعدة أهداف منها ابتزاز ذوي المعتقلين مادياً.
كما رجح بعض الناشطين أن هذا العفو المزعوم هو محاولة للتغطية على التسجيل المصور الذي نشرته الغارديان موخرا ويظهر في عملية إعدام بحق 41 مدنياً على يد عناصر من قوات النظام في حي التضامن الدمشقي.
———————————-
سوريا… بلد الاعتقال الرهيب/ إيناس حقي
مرت السنوات العشر الأخيرة على السوريين كأنها كابوس طويل لا ينتهي، وخرجت من هذه المأساة فيديوهات عديدة تروي بعض جوانبها الرهيبة لشعب رفع صوته في وجه الطغيان، فواجه آلة عنف طحنت أحلامه وقتلت أبناءه وبناته في مجزرة مستمرة، ما زالت حقائقها تتكشف شيئاً فشيئاً. ولكن مأساة المغيّبين قسرياً ظلت الأفظع والأكثر إيلاماً لأنها في الخفاء، ولأن ما تسرب منها لا يمكن أن يستوعبه عقل، ولأن صور قيصر المسربة حولت هذا الكابوس المرعب إلى حقيقة مروعة.
على مر السنوات الأخيرة، لا أعرف سورياً -موالياً كان أم معارضاً- لا يعرف شخصاً معتقلاً. فسلاح الاعتقال كان وما زال مسلطاً على رقاب السوريين. وقد تنوعت القصص التي نسمعها والتي تصف معاناة عائلات المعتقلين، والتي ترسم طيفاً من حكايات نسج الأمل والتشبث بحلم عودة تبدو مستحيلة لكل أولئك الذين ابتلعهم الوحش.
سمعت يوماً عن امرأة باعت منزلها لتعطي ثمنه لسمسار ادعى معرفة أخبار عن ابنها المغيب قسرياً، وبعد أن بقي لها من حياتها حقيبة سفر، سرق السمسار النقود ولم يخبرها بشيء. سمعت أيضاً حكاية أم فٌقد ابنها منذ أحد عشر عاماً فقلبت صور قيصر المسربة صورة صورة بحثاً عنه ولم تجده. سمعت عن عائلات رفضت الخروج من سوريا رغم التضييق الشديد على أمل خروج أحد أفرادها من المعتقل. سمعت عن صديق شاهد فيديو لمعتقلين محررين فظن أنه رأى والده بينهم ولكنه اكتشف لاحقاً أنها كانت أمنية قلبه. سمعت قصة الأم التي استلمت هوية ابنها واحتفظت بالخبر لنفسها عاماً كاملاً كي لا تقتل أمل إخوته بلقائه.
التقيت بأشخاص كثر في أوروبا يعيشون في انتظار دائم، تجلس معهم إلى طاولة الطعام، فيقولون: “هذه أكلة أخي المفضلة” أو زوجي كان يحب هذه الفاكهة، أو هذا طبق أختي المحبب. ويمضغون اللقمة التي تعلق في حلوقهم.
شهدت مظاهرات وتجمعات، تحضر فيها عائلات تحمل صور أحبابها المغيبين وتعيد رواية حكاياتهم وكأنها تخشى عليهم من النسيان.
تذكرت تلك القصص وأنا أشاهد الصور التي خرجت من مدينة دمشق ومن صيدنايا لعائلات يائسة تنتظر، وفكرت في آلة العنف الرهيبة التي جعلت كل هؤلاء ينتظرون ويتألمون بصمت لسنوات حتى نسي العالم وجودهم. تختصر صورة معتقل محرر يبدو على وجهه الذهول وعائلات حوله حاملة صور أبنائها، عله يتعرف إليهم. إنها حالة هذا البلد الرهيب، حيث لا قوائم ولا أسماء ولا حقائق، وحيث الإخفاء والتسريب هو القاعدة، وحيث تزدهر الإشاعات التي تتلاعب بآمال المنتظرين.
منذ أيام، التقى الآلاف من كل أنحاء البلاد، وانتظروا وصول باصات تنقل عشرات من المعتقلين، ترميهم في الطريق فيركض المنتظرون للقائهم، فيخيب أمل آلاف منهم. ومع ذلك، فإن عودة معتقل واحد تكفي لإذكاء شعلة الأمل بأن ما جرى مع آخرين يمكن أن يكون في المرة القادمة من نصيب أحد المنتظرين.
تذكرت القصص الرهيبة عن المعتقلين في فترة الثمانينيات في عهد الأسد الأب، وفكرت أن هذا الكابوس ليس وليد مشهد البارحة، بل لعله يعود إلى عقود من القهر والعنف اللذين لا يزالان يحكمان إيقاع حياتنا اليومية، داخل بلدنا المرعب وخارجه. فعائلتي نفسها فقدت ابن عم في المعتقلات وعاد منها آخر مولوداً من جديد بعد ستة عشر عاماً من الاعتقال والتغييب القسري في سجن تدمر الرهيب.
تذكرت أيضاً سنوات الثورة الأولى، عندما كان أصدقائي يعتقلون بالجملة، وما إن يخرج أحدهم حتى يعتقل ثلاثة آخرين، بعضهم عاد، والبعض الآخر ابتلعته السجون دون أن نعلم عنه شيئاً، بعضهم نجح بالتعافي من التجربة والبعض الآخر ما زال يواجه كوابيسه يوماً بعد يوم.
أحب أن أخبر من يسألني عن سبب اختياري لمهنة الإخراج أنني أرغب في أن أكون صوت من لا صوت له، ولكنني في المقابل منذ بداية الثورة أفكر في موضوع الاعتقال في سوريا. المشكلة الحقيقية في تقديم حكاية المعتقلات السورية أنها تفوق احتمال أي مشاهد، وأن العاملين في السينما لا يستطيعون إعادة إنتاج عالم ديستوبي مماثل، فمن ذاك القادر على مشاهدة الجحيم على الشاشة؟ عملنا لمدة أعوام على مشاريع متعددة خرج أحدها للنور وما زال بعضها قيد الإنجاز. لكن الفن الدرامي عاجز فعلاً عن تصوير حقيقة هذه التجربة المريعة.
لا يستطيع وصف التجربة إلا من عايشها. لذا ولدت تجارب كثيرة وثائقية تحاول تسجيل شهادات المعتقلين، وقد شكلت هذه الشهادات وثيقة مهمة وأساسية لحفظ الحقيقة، لكن الخطير هنا هو أن نبش هذه الذكريات التي عاشها المعتقل مؤذ للغاية إن لم يترافق مع رعاية نفسية، ومع إعداد صحيح لفريق الإعداد والتقديم الذي يجب أن يقارب الموضوع بحساسية ودقة.
في غمرة هذه التحديات، يبقى الصوت عاجزاً عن الوصول، والحلم قائماً بأن يغلق هذا الملف المروّع من حياة السوريين، مرة، وإلى الأبد، بتبييض السجون ومحاسبة المسؤولين عن تلك المأساة الرهيبة. والأهم كشف الحقيقة كاملة كي يغلق أيضاً ملف الانتظار المؤلم والقاسي. حتى ذلك اليوم، يبقى القلب راجفاً منتظراً وهو ينظر إلى العائلات المتألمة وينسج معها خيوط الأمل والخيبة.
رصيف 22
—————————–
استثمار الأسد في العفو/ عبسي سميسم
بعد يومين من تفجّر الأنباء عن مجزرة التضامن في دمشق التي ارتكبها النظام السوري عام 2013، والتي صنعت قضية رأي عام ضد جرائمه تسببت بإرباك شديد له، أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوم عفو عن الجرائم الجنائية والإرهابية التي لم تتسبّب في وفاة أشخاص.
كذلك اتخذ النظام مجموعة من الإجراءات، بدا أنها تستهدف إشغال الرأي العام. فغيّر وزير الدفاع، ثم عيّن رئيساً للأركان في جيشه، بعد أن كان هذا المنصب شاغراً لسنوات. إلا أن المرسوم الأبرز كان العفو الذي حاول الاستثمار من خلاله على عدة مستويات، فمن ناحية تمكّن من إشغال الرأي العام السوري عن المجزرة بموضوع المعتقلين، كما حاول أن يصوّر الموضوع داخلياً على أنه مصالحة وطنية، ودولياً على أنه إحدى خطوات بناء الثقة مع المجتمع الدولي، تطبيقاً لمبادرة المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن “خطوة بخطوة”، التي كان رفضها سابقاً.
ويحاول النظام من خلال المرسوم تجنّب عقوبات إضافية على خلفية مجزرة التضامن. إلا أن الغموض الذي اكتنف تأويل التعليمات التنفيذية للمرسوم، والتي لم يتوضح خلالها من المعتقلين الذين سيشملهم المرسوم، وعدم إصدار قائمة بأسماء الذين سيتم الإفراج عنهم، إضافة إلى إفراج النظام عن عدد ضئيل من المعتقلين لم يتجاوز 400 شخص حتى الآن معظمهم من المعتقلين حديثاً، مقارنة بمئات آلاف المعتقلين في السجون منذ بداية الثورة، يشي بأن النظام غير جاد بحل قضية المعتقلين من خلال هذا المرسوم.
كما أن محاولة النظام إشغال الرأي العام عن مجزرة التضامن قلب السحر على الساحر، إذ كشفت صور آلاف المواطنين الذين جاؤوا بانتظار معتقليهم الكم الهائل من المعتقلين داخل سجون النظام والذين كان ينكر وجودهم أصلاً، فعمد إلى تفريق حشود المواطنين وتهديدهم عبر أجهزته الأمنية لعدم التجمّع. كما أن العدد القليل من المفرج عنهم، وإفساح المجال أمام السماسرة للتدخل كوسطاء من أجل إدراج أسماء معتقلين ضمن قوائم المفرج عنهم، يشي بأن النظام يحاول أن يستثمر المرسوم مالياً، ويبتز المواطنين مقابل الإفراج عن أبنائهم.
مهما يكن من أمر هذا المرسوم، فهو لا يؤسس لأي خطوة على طريق مصالحة أو حل سياسي، ما لم يترجم بخطوات عملية يتم خلالها الإفراج عن مئات آلاف المعتقلين ويتبين من خلالها مصير عشرات آلاف المختفين في سجون النظام.
العربي الجديد
——————————-
النظام السوري يصدر عفوا عن المعتقلين يهدف إلى تحويل الرأي العام عن مجزرة حي التضامن/ منهل باريش
نجح النظام السوري بتشتيت أنظار ملايين السوريين عن مجزرة حي التضامن الدمشقي والتي نفذها المحقق في الفرع 227 «فرع المنطقة» التابع لشعبة المخابرات العسكرية، المساعد أمجد يوسف وقائد ميليشيا الدفاع الوطني في الحي، نجيب الحلبي في 16 نيسان (أبريل) 2013 حيث أعدما 41 مدنيا بالرصاص بطريقة بشعة للغاية، ووثقا المجزرة بكاميرا هاتف خليوي، نشرتها صحيفة «الغارديان» مؤخرا، وتحقيق الباحثان، السورية أنصار شحود والتركي المتخصص بدراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة أمستردام، أور أوميت أونغر.
وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن «الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين» قبل تاريخ 30 نيسان (ابريل) الفائت. ونص المرسوم على منح عفو عما وصفه بـ«الجرائم الإرهابية» عدا عن التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته، بدون ان يؤثر على دعوى الحق الشخصي.
أولى مظاهر حرف الرأي العام السوري عن مجزرة التضامن تجلى بالسماح لمئات من أسر المعتقلين بالتجمع تحت جسر الرئيس في قلب العاصمة دمشق وفي أكثر المناطق حيوية، ولم يكتف النظام بترك الأهالي يتجمعون، بل بث الإعلام الموالي تقارير مع ذوي المعتقلين الحالمين بسماع خبر يعيد أبنائهم من الاختفاء القسري قبل عشرة أعوام.
مرسوم العفو خلق حالة من الفوضى في صفوف المؤيدين للثورة السورية، مبررة لأسباب كثيرة، حيث انتشرت قوائم قديمة للمعتقلين على أنها قوائم للمفرج عنهم، وساعد النظام بذلك بشكل مقصود بسبب عدم نشر قوائم من قبل محكمة الإرهاب بوصفها الجهة صاحبة الاختصاص.
يعتبر سجن صيدنايا سيء الصيت أكبر المعتقلات السورية وفيه يقبع عشرات الآلاف من المعتقلين وعليه تتركز أعين السوريين في البحث عن أبنائهم من المعتقلين الأوائل، خصوصا الذين قطعت أخبارهم، فيؤمل الأهالي أنفسهم بوجود معتقلهم فيه.
ومع انتشار الشائعات حول أعداد المفرج عنهم، قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أنها وثقت الإفراج عن 103 من السجن المذكور يوم الخميس. وأطلقت الرابطة حملة استجابة للرد على استفسارات الأهالي وتقديم الدعم النفسي والمساعدة في عملية البحث وتقديم المشورة والنصح والتوجيهات أو السؤال عن المعتقل أو المختفي قسراً ولتجنيبهم عمليات الابتزاز والخداع خلال الظروف الحالية، «يمكنكم الاتصال بنا في أي وقت على مدار الـ 24 ساعة»
وأشارت في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه «شهد وسط العاصمة دمشق وبلدة ومعرّة صيدنايا مظهر احتشاد آلاف العائلات يومياً في انتظار سيارات عسكرية قد تحمل المغيّبين لسنوات في سجون النظام السوري لترمي بهم على قارعة الطريق هناك، من دون أن يكون لدى بعضهم القوة الجسدية أو القدرة العملية على الوصول إلى بيوت ربما دمرتها براميل النظام المتفجرة أو عائلات قضى كلها أو بعضها أو أنها هربت من القتل أو أجبرت على النزوح ولم يبق منها أحدٌ لينتظر غائباً في سجون النظام».
وأشارت الرابطة إلى «أن استكمال بيانات المفرج عنهم جميعاً وتوثيقها يحتاج وقتاً أطول وإجراءات متأنية نظراً لحساسية هذه المعلومات وضرورة توخي الدقّة البالغة فيها قبل نشرها حرصاً على مشاعر وسلامة العائلات».
وفي السياق، أكد العضو المؤسس والمشارك في الرابطة والمعتقل السابق، دياب سرية في اتصال مع «القدس العربي» تفاوت تواريخ الاعتقال للمفرج عنهم من سجن صيدنايا، ونوه إلى ان «عدد المعتقلين القدامى المفرج عنهم قرابة 15» ولفت إلى أن «غالبية المفرج عنهم من السجون المدنية في السويداء وعدرا. والتحديثات الأخيرة، التي تشير إلى ارتفاع عدد المفرج عنهم من سجن صيدنايا مخيبة لآمالنا ولم تتجاوز 120 معتقلا حتى اللحظة (ليل الجمعة)». ووصف الحملة التي أطلقتها الرابطة «حملة توعية لتجنيب أهالي المعتقلين عمليات النصب واللجوء إلى شبكات السماسرة والمرتبطين أمنيا».
وفي سياق متصل، اعتبر المحامي والناشط الفلسطيني ايمن أبو هاشم صيغة العفو أنها «التفافية من أجل التغطية على عشرات الآلاف من المعتقلين الذين فبرك النظام لهم الاتهامات وأصدرت أحكام عليهم بدون وجه حق. حيث يسعى النظام إلى تثبيت روايته بان المعتقلين ارتكبوا جرائم إرهابية واليوم يتم العفو عنهم».
في آلية التنفيذ، انتقد أبو هاشم ما جرى وأوضح ان العفو يعطي محكمة الإرهاب «سلطة تقديرية واسعة من أجل إخفاء هوية الضحايا بمعنى ان كثيرا من القضايا التي تم الفصل بها، مثل قيام متهمين بمهاجمة مؤسسات حكومية نرى ان تلك الأحكام لم تحدد أسماء الضحايا وهذا ما يؤكد فبركة الاتهامات».
وعدم ذكر «ضحايا» النظام في تلك الهجمات من التابعين للمؤسسات الحكومية يترك سيف القرار بيد محكمة الإرهاب ويمكن المحكمة من الالتفاف على القانون نفسه وتفريغه من محتواه حتى لو افترضنا أن مرسوم العفو نفسه يرغب بتشميل أعداد كبيرة من المعتقلين. ويرى أبو هاشم أن الهدف الأساسي هو ترك الأمور بحيث يتم إيهام الرأي العام انه صدر عفو يشمل آلاف أو مئات آلاف السوريين، ولكن في حقيقة الأمر لم يشمل سوى فئة محدودة وهي الفئة التي لم ترتكب أي جرائم إرهابية وانما الصقت بها تلك الجرائم.
أهداف سياسية
يهدف النظام السوري لإرسال عدة رسائل سياسية للخارج والداخل بإصدار العفو، فهو يأتي بعد أيام من انفضاح مجزرة التضامن ولذلك يحاول إلهاء السوريين بقضية أخرى. خصوصا وأن المجزرة أثارت الرأي العام الدولي وحشرت النظام في الزاوية مجددا، ولن يستطيع النظام تبرئة نفسه كون المجزرة موثقة بالصوت والصورة وبكاميرا القتلة أنفسهم. كما أن النظام يكرر محاولات إظهار نفسه على انه يحاول معالجة ملف المعتقلين كملف أساسي من ملفات الحالة السورية والإيحاء بأنه يستجيب للمطالبات الدولية المتعلقة بملف المعتقلين، ويأتي بعد إحاطة بيدرسون الأخيرة في مجلس الأمن الدولي والتي تحدث فيها عن المعتقلين، ومن غير المستبعد أن يكون توقيت العفو مرتبطا بمحاولة النظام فتح خطوط اتصال مع واشنطن مجددا فيما يتعلق بالرهينة الأمريكي تايس.
ولفت المحامي محمد صبرا إلى أن العفو ليس الأول، والإفراج عن معتقلين منذ 2012 يدل على أن كل قوانين العفو السابقة ومنها هذا القانون «ليست جدية وليست حقيقية» وأضاف لـ«القدس العربي» أن العفو «مجرد وسيلة من الوسائل التي يتبعها النظام في إدارة أدواته السياسية سواء الداخلية أو الخارجية».
فوضى القوائم
وخفف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من التعويل على العفو مشيرا إلى ان المفرج عنهم حتى يوم الجمعة وتمكنت الشبكة من توثيق أسماءهم هم 195 بينهم 24 سيدة، وشدد على ألاعيب النظام حيث أن أقل من ثلث المفرج عنهم هم من المحكومين والذي يفترض ان يشملهم نص العفو، وتوثق الشبكة التي يرأسها عبد الغني 132 ألف معتقل.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة جديدة من المعتقلين تضم نحو 128 شخصا جلهم من أبناء مناطق دمشق وريفها والقنيطرة، جرى الإفراج عنهم من مبنى محافظة ريف دمشق في منطقة المرجة، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الفائتة بقضايا جنائية وبعضهم الآخر ممن كان معتقلا لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وأحصى المرصد نحو 426 مفرجا عنه معتبرا أنه «رقم ضئيل جداً، حيث من المفترض أن يُفرج عن آلاف، بل عشرات الآلاف من المعتقلين».
في المقابل، أكدت رئيسة محكمة الإرهاب القاضي زاهرة بشماني عدم صحة وجود قوائم تتضمن أسماء المفرج عنهم وفق مرسوم العفو. واتهمت من وصفتهم ضعاف النفوس بنشر قوائم مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت في اتصال مع قناة السورية رصدته «القدس العربي» أنه تم في الأيام الماضية إطلاق سراح المئات ممن شملهم المرسوم بعد البحث والتدقيق بكل الملفات سواء المنظورة بحق الموقوفين أو التي تم إصدار أحكامها القضائية التي تكتسب درجة القطعية مشيرة إلى أنه يتم حالياً بالتعاون مع كامل الكادر القضائي والعاملين بالمحكمة متابعة الملفات المتبقية للنظر بمطابقتها لشروط المرسوم. وعن سبب عدم وجود قائمة رسمية للمفرج عنهم، أشارت رئيسة محكمة الإرهاب إلى أنه «لا يحق لأي محكمة إصدار قوائم بأسماء المشمولين بالمرسوم لأن ذلك مخالف للقانون أصلاً».
القدس العربي
——————————
قانون العفو عن الشبيحة!/ مصطفى محمد
دقائق ثقيلة من البحث بين صور المعتقلين المُفرج عنهم من أبناء حلب مرت على الشاب محمد، الذي كان يستحضر في ذهنه خيالات وجوه كل المعتقلين الذين يعرفهم أملاً في التعرف على واحد من بين 43 معتقلاً مشمولاً ب”العفو” وصلوا الى مبنى المحافظة.
شبيح مفرج عنه
أثناء تدقيقه بالصور صادف وجهاً يبدو مألوفاً، ركّز على ملامحه أكثر: “هذا فؤاد من قريتي كفر حلب”. يضحك كما الطفل، قبل أن يتحدث ل”المدن”: “هذا شبيح كان يقاتل مع مجموعة تابعة لفرع المخابرات الجوية، واسمه فؤاد أحمد محمد”.
ويؤكد محمد الذي زوّد “المدن” بصورة فؤاد عندما كان يقاتل إلى جانب جيش الأسد، أن النظام اعتقله قبل أقل من عام بعد خلاف نشب بينه وبين عناصر مجموعته على تقاسم المسروقات، مضيفاً “عندما تقدمت قوات النظام إلى كفر حلب جنوب غرب حلب، في شباط/فبراير 2020، قام فؤاد بالتنسيق مع الشبيحة وتوجه إلى حلب، وأمضى مدة طويلة وهو يقاتل معهم، إلى أن اختلف مع أفراد مجموعته على المسروقات، وتم سجنه لأنه غير مدعوم” أو لأنه “شبيح صغير”.
خروج فؤاد من المعتقل، تنفيذاً لمرسوم “العفو” عن الجرائم الإرهابية الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل أيام، يؤكد عدم جدية النظام في إخراج معتقلي الرأي، كما تؤكد مصادر المعارضة.
وفي السياق ذاته، يؤكد مصدر ل”المدن” أن غالبية المعتقلين المُفرج عنهم في حلب، من المحكومين بأحكام جنائية (سرقة، مشاجرات، ترويج مخدرات)، وجرى اعتقالهم قبل مدة وجيزة.
معتقلو رأي مرضى
وتضيف المصادر أن النظام أطلق قلة من المعتقلين السياسيين، بعضهم أصحاب أمراض جسدية مزمنة، أو يعانون من فقدان الذاكرة، مبينة أن “النظام أراد تطعيم دفعات المعتقلين بمعتقلين سياسيين، حتى يكمل مسرحيته، مدعياً جدية مهزلة العفو بإطلاق سراح المعتقلين، لكن في الواقع هو يقوم بإطلاق سراح سجناء الجرائم الجنائية”.
وهو ما يؤكد عليه، الخبير الدستوري القاضي خالد شهاب الدين ل”المدن”، مبيناً أن “النظام لم يطلق إلا عدداً محدوداً من معتقلي الرأي الذين لا يُعرف مصيرهم”.
ويشير شهاب الدين إلى حجم التجمعات البشرية التي سجلتها دمشق في الأيام الأخيرة، ويقول: “هذا المد البشري الهائل من ذوي المعتقلين، يعد شاهداً على العدد الضخم للمعتقلين بسجون ومعتقلات الأسد”.
ويقول إن “المرسوم (العفو) المهزلة، جاء لتحقيق أهداف النظام، وليس لإطلاق سراح المعتقلين، وتوقيته المتزامن مع الكشف عن مجزرة التضامن، يعد دليلاً دامغاً على كذب النظام، وسعيه إلى صرف أنظار الأوساط المحلية والدولية عن بشاعة الجريمة التي نفذتها قوات النظام في نيسان/أبريل 2013 في محيط العاصمة دمشق”.
إجراء كاذب
ويدل على ذلك، بعدم الإفراج الفوري عن المعتقلين المشمولين ب”العفو”، وهو الإجراء المُعتاد، موضحاً أن “مفاعيل مراسيم العفو غير قابلة للتأجيل، وحتى لو تم الطعن بها من قبل النيابة العامة”، مستدركاً بقوله: “ليس عفواً هذا الذي أعلن عنه النظام، وإنما هو إجراء كاذب يخدم غاياته، ورغبة بعض الدول التي تسعي إلى إعادة تعويمه”.
ولم يُعلن النظام السوري عن أعداد المعتقلين المشمولين بالعفو، في الوقت الذي تقدر فيه مصادر حقوقية عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم حتى مساء الجمعة بنحو 500 من كل المحافظات السورية، غالبيتهم من المناطق التي أجرى النظام فيها “مصالحات” مع الأهالي، في درعا وريف حمص وأرياف دمشق.
ويقول شهاب الدين إن النظام السوري اعتقل مئات الشباب من مناطق التسويات، لغرض إطلاق سراحهم في وقت لاحق، لتلميع صورته، مختتماً: “وهذا ما يجري الآن”.
وطبقاً لأرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يصل عدد المعتقلين لدى جميع أطراف الصراع السوري بنحو 150 ألفاً، 88 في المئة منهم لدى النظام السوري، ومات منهم 14 ألفاً تحت التعذيب.
المدن
————————-
هكذا نجا الأسد من الاغتيال وعفا عن المعتقلين/ عمر قدور
من المحتمل جداً أن يكون بشار الأسد قد خالف سيناريو إيرانياً ينص على تعرضه لمحاولة اغتيال، أثناء وصوله لأداء صلاة عيد الفطر في جامع الحسن في حي الميدان الدمشقي. إعلام الأسد نفى خبر محاولة الاغتيال، بينما نشرته وكالتا “مهر” و”إيسنا” الإيرانيتان نقلاً عن خبر عاجل أوردته قناة المنار!
ربما يكون قد خالف أيضاً المخطط الإيراني فاختار مسجداً غير ذاك الذي ينبغي أن يشهد محاولة الاغتيال، فاختياره جامع الحسن في الميدان له دلالة يعرفها السوريون جيداً؛ لقد اختار مكاناً كانت تنطلق منه المظاهرات في عام 2011. بهذا الاختيار، أراد الأسد التأكيد على انتصاره، بل التشفي بالذين ثاروا ضده، ولا يستوي مع الاثنين أن يتعرض لمحاولة اغتيال تجعل منهما منقوصين أو محل شك. هو أيضاً، على الأرجح، لا يحب محاولات الاغتيال وإن أتت وهمية بتدبير من أهل البيت.
ربما، على عجل، أتت الفكرة: لماذا لا يكون هناك عفو عن المعتقلين يُحدث الضجة التي كان يُفترض أن تُحدثها محاولة الاغتيال؟ في الحالتين، سيكون الأسد في مركز الاهتمام، إن نجا وإن عفا، والثانية منهما تعزز من فكرة انتصاره، وتُذكّر بأنه القوي المتحكم الذي يمسك بيديه حيوات ما يزيد عن مئة ألف معتقل. وداعاً للأضواء التي سُلّطت على أمجد يوسف، وينبغي أن تعود الأضواء إلى مستحِقها عن جدارة أكبر.
هكذا كُتب لمجرم “مجزرة التضامن” أن يتسبب بالمهزلة التي أتت لسرقة الأضواء منه، إذ يجب أن ينسى العالم فظاعة “حفرة التضامن” وينشغل بـ”مكرمة” العفو غير المخطط لها أصلاً. لكن لا لسوء التدبير فقط، أتى إطلاق سراح مئات المعتقلين ليؤكد على طبيعة السلطة، فيكون العفو تماماً بمثابة مجزرة جديدة. وعلى منوال المجزرة التي يُراد طمس أخبارها، تكون فظاعة مجزرة العفو بكونها دلالة على المخفي الأشد هولاً. الألوف من أهالي المعتقلين، الذين تجرؤوا وتجمهروا في ساحات رئيسية في دمشق لسؤال الخارجين من المعتقل عما إذا التقوا هناك بأحباء لهم، هم أيضاً رأس جبل الجليد من بين مئات الألوف الذين لم يشاركوا بسبب الخوف أو اليأس أو البعد الجغرافي، بما في ذلك تهجيرهم خارج البلاد.
ويستحق منا ما حدث أن ندحض فرضية سوء تدبير مستجد، لأن ما يحدث سبق للسوريين معايشته بعيداً عن الكاميرا التي صارت لاحقاً متاحة في جيب أي حامل موبايل. في مثال ليس الأقسى، لكاتب هذه السطور قريبان اعتقلا في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، ومن دون أن تُعرف صلتهما الفعلية بالتنظيم لغياب أية محاكمة علنية. منذ لحظة الاعتقال، لم تعد هناك إطلاقاً أخبار عنهما؛ كبر الأولاد ثم الأحفاد ولا أخبار. ماتت أمهما وهي تقول “الله يذكره بالخير” عندما تأتي سيرة أي منهما لتؤكد لنفسها وجودهما على قيد الحياة، وقد عرفتْ مدناً وبلدات وقرى وهي تحمل صور ابنيها وتذهب لعرضها على معتقل أُفرج عنه هنا أو هناك من دون أن تحظى بخبر عنهما. ولو ملكتْ نصف كيلو من الذهب “هو التسعيرة المعروفة لزوجة مدير سجن شهير” لضحّت به على أمل الحصول على مجرد خبر عنهما، رغم المخاطرة بخسارة الذهب بلا خبر.
أشيع، في سبب حدوث التجمعات الأخيرة لأهالٍ يشبهون تلك الأم، أن سائقاً أشفق على المفرج عنهم لدى مروره من أمام السجن، فأقلّهم إلى منطقة “جسر الرئيس” لكونها عقدة للمواصلات. وإذا نحّينا ما قيل عن فقدان الذاكرة الذي أصيب به تحت التعذيب العديد من المفرج عنهم، فإن وجهاً من الفظاعة يبرز في عدم إيصال فاقدي الذاكرة على الأقل إلى ذويهم. في التسعينات، عندما أفرج الأب عن معتقلين من سجن تدمر، كانت سيارات السجن توصلهم إلى كراج الحافلات الرئيس في حمص، ويُعطى كل منهم مبلغ مئة ليرة ثمن تذكرة موحد إلى وجهات مختلفة قد لا يكفي المبلغ للوصول إليها. نعم، هي مئة ليرة؛ الفارق بين الأمس واليوم.
ولا لمرة، في عهد الأب ثم الابن، خرج من يقول أن هناك عفواً عاماً حقيقياً وأخيراً؛ تعبير “تبييض السجون” ليس له وجود في قاموس السلطة. كان يمكن لو حدث ذلك في التسعينات مثلاً أن يكف الأهالي عن انتظار أبنائهم الذين لا يعلمون شيئاً عن مصيرهم، وأن يتجرعوا الإعلان عن مقتلهم رغم قسوته بديلاً عن فظاعة الانتظار وعدم اليقين. لم يكن ولن يكون هناك إعلان عن تبييض السجون، لا بسبب الإحراج من انكشاف عدد القتلى المهول، بل لممارسة تعذيب إضافي مستمر على ذوي الضحايا؛ هذا هو عقل السلطة الذي لم يتغير إلا في ارتفاع درجة استهتاره بمآسي المحكومين.
في ذلك العقل أيضاً، أن شخصاً مقرباً من السلطة يُدعى جورج.أ. نال قسطاً من جفائها في التسعينات، عندما كان الأب يرسل إشارات إيجابية إلى الغرب بعد سقوط المنظومة السوفيتية، ولحاجته إلى موافقة الغرب لضمان مشروع التوريث. حينها “ضمن مناخ الانفتاح” نشرت وسيلة إعلامية أمريكية شهيرة ريبورتاجاً عن جورج.أ، مطلِقة عليه لقب أمير مسيحي الشرق، وسرعان ما شاعت الأخبار عن غضب منه، رغم عدم مسؤوليته عن ذلك اللقب، إذ لا يجوز أن يظهر سوري “مهما كان مقرّباً من السلطة” كنجم في وسيلة إعلام عالمية.
حتى إذا كانت النجومية من نمط “نجومية” أمجد يوسف فهي مرفوضة، والتغطية عليها لا تأتي فقط من نافذة ستر عار الجريمة، وإنما أيضاً تأتي من باب وجود من يجب أن يحتكر الأضواء دائماً فلا تذهب إلى أحد سواه. لهذا أتت المناظر من دمشق وكأن غايتها التذكير بالمجزرة الكبرى التي تهون بالمقارنة معها مجزرة التضامن، والتذكير في الوقت نفسه بأن أمجد يوسف مجرد عامل صغير لا يستحق الانتباه في مصنع المقتلة الكبرى. ثم إن المجزرة التي ارتكبها قد انتهت فعلياً، بينما المجازر في مختلف السجون والمعتقلات مستمرة، وقرار استمرارها هو رهن مشيئة شخص واحد، شخص يستطيع أن يجعل من العفو مهزلة ومجزرة في آن.
بعد شهور من انطلاق الثورة، ومن ممارسة الوحشية تجاهها، كان بعض الموالين “وحتى بعض المعارضين” يرغب في رمي مسؤولية استخدام العنف على مسؤولين أدنى. حينها خرج بشار الأسد ليضحك، وليسخر في خطاب له من فكرة عدم مسؤوليته، مؤكداً أنه صاحب القرار الحصري. في قرار العفو الأخير تأكيد من الصنف ذاته، تأكيد أدى بنجاح إلى نسيان أمجد يوسف.
المدن
—————————-
ثقافة القتل في سورية/ أحمد رحّال
كان مستغرباً ومفاجئاً لكثيرين متابعين للثورة السورية في سنواتها الأولى، عشرات مقاطع الفيديو التي تُظهر عمليات القتل والتعذيب والشراسة في قتل المتظاهرين. والمستغرب أكثر، أن تلك المقاطع المصوّرة كانت تخرج من داخل أقبية الاستخبارات السورية ودهاليزها، ومن مراكز اعتقال تخضع لرقابة صارمة ومشدّدة من رجالات الأسد وقادته، في مقرّاتٍ ومعتقلاتٍ حتى خيوط الشمس لا تستطيع التسلل إليها من دون إذنهم. ولدى سؤال أطرافٍ في السلطة الاستخباراتية التي كانت تسرّب بعض الأسرار، علمنا لاحقاً أن القيادة السورية وقادة أفرع الاستخبارات السورية كانوا على معرفة واطلاع كاملين بتسريب تلك “الفيديوهات”، بل هم من كان يسرّب تلك المشاهد إلى الخارج، بقصد توجيه رسالة واضحة إلى طائفة النظام المتردّدة بحسم موقفها (بين متابع مؤيد متمسّك بكرسي حكم نظام الأسد المهدّد بالسقوط حينها، حتى لو كلفه هذا الموقف الابتعاد عن بقية السوريين، ومن يجد ملاذه الطبيعي مع كل السوريين والتخلص من هذا النظام)، وأن الغاية من المشاهد المقززة لتعذيب السوريين وقتلهم، المسرّبة من أجهزة الاستخبارات السورية، حسم المواقف المتردّدة للطائفة، وإيصال رسالة مفادها بأن كل طائفة بشار الأسد أصبحت مجرمة في نظر بقية المكوّنات السورية، وأن الجرائم التي شوهدت من الجميع لن تجعلهم يتسامحون معكم، لأنكم أصبحتم شركاء في قتلهم. وللخروج من هذا الواقع، يجب رصّ الجبهة الداخلية للطائفة، ولكل من بقي يقاتل إلى جانب النظام، وإما أن نتجاوز المرحلة معاً أو نلقى مصيرنا المحتوم. وبهذا الشكل، استطاع النظام شد عصب معظم حاضنته الطائفية وربطها بكرسي الحكم، ومعها انطلقت ثقافة الموت وثقافة القتل بين عناصره وشبّيحته، وخصوصا ما تسمّى مليشيات الدفاع الوطني التي شكلت دولة داخل الدولة، واستفردت بجرائمها وتجاوزاتها من دون سيطرة، ومن دون أدنى مركزيةٍ في عملية اتخاذ القرار.
للمجزرة في حيّ التضامن شبيهاتها في كل أحياء دمشق المنتفضة على نظام الأسد. ولا يختلف ما حصل ويحصل في دمشق عمّا فعله شبّيحة النظام في كل المدن والأرياف السورية. وفي زنازين النظام معتقلون ذاقوا كل أنواع العذاب، غير أن هذا كله يبقى تفاصيل صغيرة بين ما ارتكبه هذا النظام بحق الشعب على كامل الجغرافيا السورية.
في عام 2015 كانت فصائل الجيش السوري الحر على مقربةٍ من معتقل بلدة الشير في ريف محردة التابعة لمحافظة حماة، الذي تديره مجموعة من مليشيات الدفاع الوطني بقيادة الرجل الأخطر والأشهر في ريف المحافظة، سيمون الوكيل. ولكن خشية الفصائل كانت وقوع قتلى داخل السجن، إذا ما حدثت عمليات قصف أو اشتباكات لتحريرهم وهم عزّل داخل المعتقل، غير أن رسالة من سجين داخل المعتقل أربكت قادة الفصائل، فمن هول العذاب الذي كان يتعرّض له المعتقلون في سجون النظام وفي معتقل الشير، طالب هؤلاء بقصف السجن، حتى لو سبّب مقتلهم، فالمهم بالنسبة إليهم أن يتخلصوا من عمليات التعذيب والتنكيل التي يتعرّضون لها، حتى لو كان الثمن مقتلهم.
جريمة حيّ التضامن التي أذهلت العالم، ليس فقط لحجم القسوة في مشاهد سَوق 41 من المدنيين نحو حفرة لقتلهم، أو لحجم الإجرام الذي يتفاخر فيه بطلها، أمجد يوسف، ورفاقه من شبّيحة الأسد، بل أذهلت العالم بالهدوء والسكينة التي تحملها قلوب هؤلاء القتلة، وهم يرتكبون الجريمة، ومقدار راحة البال التي يتمتع بها هؤلاء الذين استرخصوا أرواح بشرٍ، فقط لأنهم قالوا “لا” لنظام الأسد الرهيب بالأمر أيضاً، ومن خلال تتبع مشاهد الإعدامات التي حملتها مجزرة التضامن أنها لم تكن لمعتقلين، ولا لمساجين، فالمعتقلون والسجناء لدى أجهزة أمن نظام الأسد، بحسب خبراتنا مع عمل تلك الأجهزة، تكون ظاهرة عليهم ملامح هزالة الجسد وآثار التعذيب، ولكن أجسام من قتلوا في مجزرة حيّ التضامن سليمة، ولا آثار للتعذيب عليهم، وهذا يعني أنهم تعرّضوا للاعتقال التعسفي الذي تمارسه سلطات الأسد عادة على الحواجز داخل أحياء المدن السورية، أو اعتقلوا من بيوتهم ثم جرت تصفيتهم مباشرة بتلك الطريقة الوحشية، حتى دون مسرحيات المحاكم الصورية التي اعتاد نظام الأسد تقديمها للشعب السوري في بعض الأحيان. والمؤلم في تلك الجريمة أن من جرت تصفيتهم اقتيدوا معصوبي العيون إلى مواقع حتفهم في تلك الحفرة الرهيبة، وأن من قتلهم استصعب عملية حملهم بعد قتلهم، لذلك تخلّص منهم على حوافّ تلك الحفرة بعد أن ساقهم إليها، وقد تكون انهالت عليهم الأتربة لإخفاء الجريمة، وهناك من لا يزال من بينهم على قيد الحياة، وقد دُفنوا أحياء.
مجزرة التضامن واحدة من آلاف المجازر التي ارتكبتها أجهزة الاستبداد في نظام الأسد، من مجازر قصف ومجازر براميل ومجازر أسلحة كيماوية وسياسة أرض محروقة، وحصدت كلها أرواح عشرات آلاف السوريين، وستبقى في نفوس السوريين، ما دام نظام الأسد في السلطة، وستؤسس لحقد بين مكونات السوريين لن تزول قبل أن ينال المجرمون ما يستحقونه من حسابٍ عبر قضاءٍ عادل.
ولكن، لو تتبعنا انتشار خبر مجزرة التضامن، لن تجد سورياً واحداً فوجئ بتفاصيل الجريمة، لأن الشعب السوري عايش العشرات من تلك الجرائم التي ارتكبها شبّيحة النظام بحقّ السوريين على مدار سنوات الثورة وحتى ما قبلها، وشاهد هذه الجرائم وسمع عنها. وقد أتقن هؤلاء الشبّيحة وامتلكوا ثقافة القتل والإجرام التي زرعها نظام الاسد، وصنعتها أجهزته الأمنية في عقول مؤيديه. فمن شعار “الأسد أو نحرق البلد”، إلى شعارٍ يمنح الأسد صفة الألوهية، إلى قول ماهر الأسد: “استلمنا السلطة في سورية وتعداد سكانها سبعة ملايين نسمة وسنعيدها كما استلمناها”. ويعطي ذلك كله مؤشّرات واضحة وجلية على عمق تجذّر الجريمة ومفاهيم القتل في نفوس تلك الحفنة التي يأسف السوريون أن هناك اليوم من يحاول إعادة وصل العلاقة معهم، أو فتح صفحة جديدة وتجاوز الجرائم التي ارتكبوها.
أيضاً، من حق السوريين العتب واللوم على كل قادة العالم الذين أذهلتهم وفاجأتهم مجزرة التضامن، وأن يذكّروهم بمناشدات وصيحات عديدة أطلقوها إليهم، وهم يحذّرون من إجرام هذا النظام، لكن العالم بقي متفرّجاً أو مشكّكاً في رواية السوريين، حتى عندما ارتكب نظام الأسد مجزرة السلاح الكيميائي ضد المدنيين في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، متجاوزاً آخر الخطوط الحمراء التي حدّدها الرئيس الأميركي، في حينه، باراك أوباما. ما حصل أن العالم الحرّ اكتفى بسحب سلاح الجريمة، وترك المجرم طليقاً ليكمل جريمته بحق السوريين، وهانت على العالم الحر أرواح أكثر من 1400 مدني قتلوا على يد النظام من أطفال ونساء وشيوخ.
مجزرة التضامن غيض من فيض جرائم هذا النظام التي ستصيب العالم بالهول، عندما يعلمون كامل تفاصيل ما حدث على المسرح السوري خمسة عقود. ومقتل 41 مدنياً سورياً ليس علامة فارقة في نظر السوريين أمام معرفتهم بأجندات هذا النظام وإجرامه ونهجه. وليس بإضافةٍ يمكن أن تقدّم لتوثيق مأساة السوريين التي تجاوزت 14 مليون مهجر ونازح وأكثر من مليون شهيد، ومثلهم من المعتقلين والمغيبين قسراً في غياهب معتقلات الأسد وزنازينه. إنما يعوّل السوريون على أن تكون تفاصيل تلك المجزرة وهولها وخزة ضمير لقادة الغرب على الخطأ الذي ارتكبوه بحق الشعب السوري، عندما أهملوا المقصلة والمدحلة التي يتعرّض لها على الأرض السورية على يد نظام الأسد.
يأمل السوريون أن تكون مشاهد مجزرة التضامن صرخةً توقظ قادة الغرب للعودة إلى الوقوف إلى جانب شعب دمّره الأسد، فقط لأنه طالب بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. فهل تكون هناك عودة غربية وعربية وإقليمية لإنصاف شعبٍ بعد مأساة طال زمنها، أم أن لغة المصالح السياسية لدى قادة الغرب مقدّمة على لغة الإنسانية وحرية الشعوب؟
العربي الجديد
—————————-
مقابلة خاصة.. معتقلة أفرج عنها النظام تروي 8 سنوات في الجحيم وتنقل “وصية العروس“
تلفزيون سوريا – خاص
خرجتْ من المعتقل منذ ثلاثة أيام، بعد أن قضتْ ثماني سنوات في معتقلات النظام، وحين طلبَ منها موقع “تلفزيون سوريا”، إجراء هذه المقابلة، اشترطت نشر كل المعلومات التي سترد خلال إجاباتها، وخصوصاً “وصية العروس”.
أنا فتاة سورية، لي عدّة أسماء، ففي فرع فلسطين مثلاً، كان اسمي 3/5، رقمي ثم رقم غرفتي، وفي سجن المزة العسكريّ صار اسمي 2/32، أما خلال جلسات التحقيق يغدو لي أسماء كثيرة، يستطيعُ معظم السوريين تخمينها، سأجيبُ عن كل الأسئلة، وآملُ أن تتسعَ سطور مقابلةٍ واحدة لرواية ثماني سنوات، قضيتها معتقلةً بين فرع الأمن العسكري وفرع فلسطين وسجن المزة وصيدنايا.
السبت الماضي، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد المرسوم رقم 7، المعروف بـ “مرسوم العفو” عن مرتكبي “الجرائم الإرهابية” في سوريا قبل تاريخ 30 من نيسان الماضي.
أجرى موقع “تلفزيون سوريا” مقابلة مع إحدى النساء المعتقلات، والتي أفرج عنها حديثاً، نتحفظ على ذكر اسمها لأسباب تتعلق بسلامتها، تروي فيها قصة اعتقالها الذي دام ثماني سنوات تنقلت فيها ضمن أربعة سجون للنظام السوري، ذاقت فيها صنوف العذاب الذي تصفه بـ “الجحيم”.
*بدايةً، ما أسباب وظروف اعتقالكِ؟
أستطيعُ أن أؤكد لكَ، أن اللامبالاة التي صبغت بعض سلوكنا الثوري، كانت سبباً في اعتقال المئات من الناشطين، ومنهم أنا، لقد كنتُ حذرةً جداً عند ممارسة أي نشاط ثوري، لكنّ حمى التصوير التي أصابت بعض الناشطين الإعلاميين، أدّت خدماتٍ عظيمةً للنظام السوري وأفرعه الأمنية.
حين تأكّد والدي قبل عدة سنوات، أن التهجير القسري سيكون مصيرنا لا محالة، أمّن لنا طريقاً خرجنا فيه من المنطقة المحاصرة باتجاه الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام، حصل هذا قبل شهرين من موعدِ تطبيق الاتفاقية، التي قضتْ بتهجير أهل منطقتنا قسراً، باتجاه شمالي سوريا، لم يكن علاجُ والدي متاحاً في تلك المناطق، ثمّ وبعد شهرين فقط من تاريخ التهجير، دهمت دوريّةُ أمن منزلنا، سألوا عني فورَ دخولهم، فقلتُ لهم :”أنا فلانة”، ليصدِر رئيس الدورية أمراً بأخذي إلى السيارة فوراً، لم يكن والدي في البيت حينها، ولم تنفع توسلاتُ أمّي، وحين تيقنتْ من عجزها، حاولتْ أن تعرفَ الجهة التي سيأخذونني إليها، فصرخ بها الضابط، وهددها بأخذ بقية إخوتي إن لم تصمت.
فور جلوسي في السيارة بين عنصرين، قاموا بتقييدِ يديّ خلف ظهري، وعصبوا عينيّ بقماشة مخصصة لهذه الغاية على ما يبدو، وهكذا سأكون خلال السنوات الثمان التالية بمجرد مغادرة الزنزانة مقيّدةً معصوبة، بعد نحو ربع ساعة، وصلنا إلى مكانٍ ما، اقتادني العنصران، صعدوا درجاتٍ ثمّ نزلوا بي أخرى، تعثرتُ خلال ذلك، رفسني أحد العنصرين على عدة مواضع في جسدي، متلفظاً بشتائم جعلتني أقفُ من فوري، استلمني منهما شخصٌ ثالثٌ، سار بي بضع خطوات، ثم توقف ففكّ قيدي ونزع عصابة عيني، فتح بعدها باب زنزانة ضيقة “منفردة”، دفعني للداخل بقوة، فتعثرتُ مجدداً بأجساد خمس نساءٍ كنَّ متكوراتٍ داخلها، كأننا نعرف بعضنا منذُ زمن سألتهنّ، فأجْبْنَ هنا الأمن العسكريّ.
* كيف كانت حمّى التصوير سبب اعتقالكِ؟
مرّت عدّة أيام ولم يطلبوا أحداً منا للتحقيق، وحين سألتُ شريكاتي في الزنزانة، تفاجأتُ بأن حالي كحالهنّ جميعاً، وأن إحداهنّ قد مضى أكثر من شهر على وصولها!
أصابتني لفظة “شهر” برعب شديد، وتساءلتُ كيف استطاعتْ أن تبقى حيةً في هذا القبر شهراً كاملاً؟
بعد يومين من تساؤلي، فتح السجان باب الزنزانة ثم لفظ اسمي، لم يمهلني الوقت الكافي للخوف، لأنّ حفلة الضرب والشتائم بدأت بمجرّد قولي له: “أنا”.
خلال ممشى طويل، تمكّن السجانُ من إقناعي باسمي الجديد” كلمة نابية”، وحرص أن أردد هذا الاسم عدة مرات وبه دخلتُ مكتب التحقيق.
سمعتُ صوت المحقق، حين طلب من السجان أن يجلسني على ركبتيّ، ثم قال لي ذات الصوت:” هلأ مو نحنا أولى فيكي من الخليجيين والأتراك”؟
لم أفهم إلى ما يرمي، لكنه وضح ذلك فوراً بتلميحاتٍ جنسية، كنتُ قد سمعتُ عما تتعرضُ له المعتقلات في سجون النظام، لذلك لم أعترض، بل دعوتُ الله أن يكتفوا بالكلام، ثمّ قلتُ للمحقق:” متل ما بدك سيدي”.
طلب من السجان أن يوقفني، ويرفع عصابة عينيّ قليلاً فقط، ضايقني النور على عيني فجأةً، لكنّ النور بهت حين بدأت صوري تظهرُ تباعاً على شاشة جوال المحقق، صورة لي في مظاهرة، أخرى أثناء قيامي ببخّ النجمات الحمراء الثلاث على علم الثورة، ثم عدة صور تظهرني في عدة نشاطات ثورية.
قال المحقق:” اوعى تقوليلي فوتوشوب”، فأجبتُهُ:” لا مو فوتوشوب سيدي، هي أنا”.
اعتبر المحققُ إقراري بدايةً جيدة، ثم أكّد أنهم لن يتعرضوا لي بالأذى، إن أخبرتهم الحقيقة، وسيحرصُ أن أنام اليوم في بيتنا.
*طالما ذكرتِ أن لديه صوراً تثبتُ مشاركتك بعدة نشاطات ثورية، بل إنك أكدتِ لهُ ذلك إقراراً، فما الحقيقةُ التي يريدها؟
كان يريد مني أن أخبرهُ عن عدَد العلويين، الذين كانوا في سجون مقارّ الإرهابيين! ثم كيف تمّ إعدامهم؟ ويؤكدُ أن ذلك حصل، قبل عدة شهور من تطبيق اتفاق الخروج، وسألني أيضاً عن مصير جثثهم؟!
كيف أشرحُ حالتي في تلك اللحظة؟ فأنا أجهلُ تماماً ما كانَ يسألُ عنهُ، وجهنّم ستكون حتماً خلف عبارة “لا أعلمُ عما تتحدث”، بدأتُ أخبرهُ عن أسماء أعضاء التنسيقية، والأسماء الحقيقية لبعض قادة الفصائل، ومواقع المشافي الميدانية. كنت أريد أن أثبت له، أني لن أخفي عنه، أي شيء أعرفه. تحاشياً للتعذيب.
اعتبر إجابتي استهزاءً، فبماذا سيفيدهُ معرفة أسماء مَن أصبحوا في إدلب، وما الجدوى من معرفة مواقع المشافي؟ والمنطقة صارت تحت سيطرة جيشه؟! لتبدأ بعدها رحلة العذاب، بالتعرفِ على الأنبوب البلاستيكي الأخضر، وقدرته على تمزيقِ جسد محشور في دولاب سيارة، ثم طرتُ على بساط الريح بفقرات ظهر مقلوبة، إضافة إلى الشّبْح والصعق بالكهرباء.
طلبتُ منهم عدة مرات أن يكتبوا ما يريدون وسأوقّع فوراً، فيقولون لي ستوقّعين رغماً عنكِ، لكنْ عليكِ أن تخبرينا قبل التوقيع، فأقولُ لهم قولوا لي ما تريدونه وسأقوله فوراً.
بعد عدة أيام من التعذيب المتواصل، طلبني المحقق، حين وصلتُ مكتبهُ أخبرني بنبرة هادئة، بأني قد أكونُ صادقةً في جزء من كلامي، فكيف لصبيّة مدنيةٍ، أن تعرف عدد المخطوفين ومذهبهم، ثمّ استدركَ المحقق بأنّ المنطقة المحاصرة صغيرةٌ، لذلكَ أنتِ رأيتِ أو سمعتِ بموضوع دفن الجثث، ثمّ تابع المحققُ بأن الإرهابيين حتماً أعدموا المخطوفين سراً، فقررَ ألا يسألني عن هذا التفصيل.
لم ينه المحققُ كلامه، وأكدَ لي أنّ أناساً مهمين، حدّثوهُ بشأني، ووعدهم بمساعدتي، لكنه اشترط لمساعدتي بقوله، يجبُ أنْ أقولَ أي معلومة، “حتى لو معلومة بتعتبريها تافهة قوليها معليش”، وذكّرني بأن أحداً لم يقترب حتى من غطاء راسي، حتى الآن.
في هذه اللحظة تدخّل السجانُ للمرة الأولى بالتحقيق، وقال مخاطباً إياي:” إن لم تقدّري مساعدة معلمنا لكِ، سنقتربُ من أماكنَ تتجاوزُ غطاءَ راسك” شعرتُ بيده على رأسي، ثم عنقي ثم كتفي كانت كلُّ خلية في جسدي تردد:” يا رب أنقذني”.
خفتُ كثيراً من يده، التي بدأت تنحدر أسفلَ كتفي، صرختُ: “اي اتذكرت شغلة سيدي” فقال المحقق للسجان أبعد يدك، ورحتُ أخبرهم بأننا كنا نسمع كل مدة، أن المسلحين كشفوا أمر مخبر للنظام، ثم نسمع أنهم نفّذوا فيه حكم القصاص، طبعاً دون ذكر أسماء المخبرين، ولا أذكر أنّ أحداً أحصى عددهم، بعد ذلك سرى حديث في الحي أثناء الحصار، أنّ الكلاب صارت خطرةً، بسببِ أكلها لحمَ الجثث، ختمتُ اعترافي بنوبة بكاء وتوسّل للمحقق كي يرحمني.
قال المحقق للسجان:” أشعل لها سيجارةً، وحين تنهيها أعدها للزنزانة، كي ترتاح ونكمل غداً”.
* ما قصةُ الكلاب والجثث؟
القصة قديمة، والجثث لشباب من حيّنا، تسللوا خارج الحصار، ثم عادوا بأدوية للجرحى، لكن رشاشاً من أعلى بناءٍ في جهة قوات النظام، قتلهم جميعاً، لم يتمكن أي من المتحاربين من سحب الجثث، فقد سقطوا في منطقةٍ مرصودةٍ للجميع، ذكر الناس بعدها أمامي، أن هناك كلاباً أكلت جثثهم، تقبلهم الله.
*هل طلبك المحقق في اليوم التالي؟
بعد جلسة السيجارة، طلبني مرة واحدة، لم يسألني أي سؤال، بصمتُ على أوراق لا أعرف محتواها، ولم أتجرّأ على سؤالهم، وبعد البصم أخبرني بأنهم سينقلونني قريباً، وفعلاً ما كادَ يمرُّ أسبوع بعد البصم، حتى حضرَ السجان، فتح الباب، ناداني للقيد وعصب العينين، دون شتائم هذه المرة، فتجرأتُ وسألته أين سينقلونني؟
أجابني بالهدوء ذاته:” رح تتمني لو أكلتكِ الكلابُ مع الجثث يا……..”
كان قد مضى على وجودي في الأمن العسكري عشرين يوماً تقريباً، حين تشاركتُ مع عدة نساء معتقلات سلاسل الجنزير، صعدنا رتلاً إلى سيارة السجن، كان رتلنا يمشي ببطء، بين صفين من عناصر الأمن، هي حفلة الوداع التي يعرفها معظم السوريين، ركلٌ بالأقدام، وضربٌ بالعصي والأنابيب الخضراء، مع الحفاظ طبعا، على تراثٍ من الشتائم، التي أجزم أنها حصريةٌ بمعتقلات بشار الأسد.
منذُ عدة ساعات، وسيارةُ السجن تنهبُ الدروب، كنت أغفو أحياناً، سمعتُ معتقلةً تذكرُ كلمة الشام، لم تكن تعنيني الوجهة، طالما أن الكلاب بانتظاري أنّى اتجهتُ، عرفتُ حين دخلنا الزنزانة أننا في فرع فلسطين وكالعادة قبل دخولنا استقبلتنا دمشق بحفلٍ، لكنهُ أقسى مما ودعتنا به مدينتي، داخل زنازين فرع فلسطين وجدتُ سوريا بكل لهجاتها، باستثناء لهجة واحدة كانت دائماً خارج الزنازين، بلا قيد ولا عصابة عيون، أرجوك لا تحذف هذه الحقيقة من المقابلة.
* أخبرينا عن تفصيل حياة المعتقل في فرع فلسطين؟
بقيتُ في الزنزانة الانفرادية مدة شهرين، شاركتني جحيمهما صبية من القلمون، كانتْ تهمتها نقلَ المتفجراتِ لمقرٍّ سريٍّ في وادي بردى.
لستُ دقيقةً في حساب عدد الأيام، ولولا وصول معتقلات جدد كل فترة، لضاع منا الزمان هناك، تعرضتُ خلال هذين الشهرين لكل أنواع التعذيب، وسمعتُ أصواتاً ليست بشرية لشبابٍ يُعذبون، لم أكن أراهم في درب التحقيق، لكني كنتُ أحسّ حرارة أجسادهم، وأسمع أنينهم، كانَ المحققون يريدون مني تفاصيل كاملة، عن ملف المخطوفين، وفي جلسة تحقيق كانت الأخيرة، قال لي المحققُ إنّ الإرهابيين التكفيريين غرروا بنا، وإن الجثث التي أكلتها الكلاب تنتمي لكل مكونات الشعب السوري.
في تلك اللحظة كانت الدماء تنزف من أماكن كثيرة من جسدي، وهناك ورم في يدي اليمنى، يؤكد بأنها مكسورة، لا أذكرُ عدد الحروق بأعقاب السجائر، أو الحروق التي أصابتني نتيجة سكبِ الشوربا المغلية على جسدي، من قِبَلِ السجانة، من وراء كل هذا الألم، صحّحْتُ للمحقق معلوماته صارخةً بوجع:” لم تنتم الجثثُ لجميعِ السوريين، كلُّ الجثث تنتمي للسُنّة فقط، أنا أعرفُ أسماءهم، وأعلمُ أنهم ذهبوا في دربِ الموتِ، على أملِ إحضارِ أدويةٍ للمحاصرين، فقتلهم رشاشُ الجيش العربي السوري”.
كان ثمن ذاك التوضيح غالياً جداً، دفعتُهُ طوال تلك الليلة،
طلبوني بعدها لحفلات تعذيب دون تحقيق، كانت المواعيد تتباعد، وهذا يحصل حين تأتي معتقلات جدد، استمرّ اغتصابُ المعتقلات، لم تكن حصص الاغتصاب متساوية، فالأمر يخضع لاعتبارات العمر والجمال وموقع أقارب المعتقلة في أجسام الثورة، حُقَنٌ لمنع الحمل، وحبوب كابتيكول لزيادة الهياج، حتى المكياج حضر في إحدى الليالي، يومها دخلت السجانة غرفتنا، نادت على الرقم 21/5، فتقدمتْ صاحبة الرقم نحو الباب، قالت لها السجانة:” زوجك فطس وقرر الضابط من اليوم يكون بداله”.
ناولتنا السجانةُ المكياج، طالبةً منا تحضير العروس كما يجب، “بدنا نزفّها للمعلم بعد نصف ساعة، وإذا صار تأخير، رح نزفكن كلكن اليوم.
كان الجميع يبكي باستثناء العروس، ذهبتْ بلا دموع، لتعود بعد وقت طويل، بلا دموعٍ أيضاً!!
جلستْ العروسُ قليلاً ثم قالت لنا:” إذا متت هون أكيد رح تعيش وحدة منكن وتطلع، أمانة تقول لكلّ الناس اللي برا إنه عاطف نجيب نفّذ تهديده، ما حبلوا منو كم وحدة، حبلوا آلاف السوريات”.
*هل بإمكانك الانتقال لمرحلة ما بعد فرع فلسطين؟ إلا إذا كان هناك تفصيل مهم يجب ذكره.
سنتان وسبعةُ أشهرٍ مضى عليّ في فرع فلسطين، منذ انتهى التحقيق الرسمي، وأنا أنتظرُ الفرج بالانتقال إلى سجن عدرا، كحال جميع من تركنَ هذا الجحيم، لكن السجانة بعد كل هذا الصبر، قرأت عدة أرقام وأكدت أن الانتقال سيكون لسجن المزة العسكري، وفعلاً تمّ نقلنا بالوداع ذاته والاستقبال، كان شكل السجن غريباً، فأكدت لنا معتقلة مخضرمة، أن هذا الهنغار منفصل عن مباني السجن، ثمّ أضافتْ أنّ الهنغار كان رحبةً للمطار، ثم قاموا بتقسيمه لعدة غرف، وهنا لا زيارات ولا جلسات قضائية ولا طلبات استرحام ولا حصص تنفس، جميعُ هذه التفاهات للمعتقلين البسطاء، أما هذا الهنغار فهو للمعتقيلن “الهاي”، ومن يدخلون الهنغار، لا يخرجون إلا إلى القبر.
لم نتعرض في الهنغار لأي تعذيب، والمكان أكثر سعة من فرع فلسطين، لكن بعد وصولنا بسنتين، بدأت رحلة الجوع الشديد، كان الطعام بالأصل سيئاً جداً وقليلاً، لكن مع منتصف العام 2018 صار هذا السيء القليل حلماً.
*كيف كان يمضي الوقت في سجن المزة؟
لا شيء يستحق الذكر، أيام متشابهة تماماً، أحضروا مرةً معتقلةً جديدة، وصلتْ كالعادة معصوبة العينين، حين أخبرتها إحدانا أنها في سجن المزة العسكري استغربت، وأكدت أنها آتيةٌ من سجن المزة، ثم أكدت لنا المعتقلةُ الجديدة، أن سجن المزة غرفٌ وزنازين منفردة، فيه تعذيبٌ ليس كهذا المكان الهادئ، يومها دار جدالٌ طويل، لا تستغربْ ففي المعتقل يغدو أي حدث جديد، مجالاّ للنقاش، مهما كان تافهاً.
بعد مرور خمس سنوات وعدة أشهر، أخذوني برفقة معتقلة من غرفتي، وثلاث معتقلات من الغرف الباقية، لم نر شيئاً خلال الطريق ولا حين نزلنا من سيارة السجن، قالوا لنا إنه سجن صيدنايا، لم يعن لي الأمر شيئاً، كانت صالة كبيرةً نظيفة، فيها إسفنجات على الأرض، نعم كان الأكلُ أكثر هنا، وكذلك حصتنا في الاستحمام، بعد نحو أسبوعين من وصولنا لذلك المكان، أحضروا معتقلاتٍ يختلفْنَ عن كل ما رأيناه سابقاً، كان في وجههن دماء، وأحاديثهن لا تعرف بؤساً، كن يضحكن، سألت إحدانا إحداهن:” إنتوا إرهاب”؟
فأجابتها إحداهنّ:” لا حبيبتي نحنا جريمتنا ناعمة وسببها الحُب”.
قبل أربعة أيام دخلت السجانة، قرأتْ من ورقةٍ ثمانية أسماء، بينها اسمي الذي أطلقه علي أبي، ثم قالت إن السيد الرئيس أصدر عفواً عاماً عنا، وإنّ كل الموجودات معنا مشمولاتٍ بالعفو، لكنّ الأمر يحتاج إلى أيام لخروج كل الدفعات، كنا نبكي ونتحرك كمن أُصِبنَ بمسّ، دون وعي منها احتضنت إحدانا إحداهن، ابتعدت الإرهابيةُ عن الأخرى واعتذرت.
*هل تحبين إضافة أي شيء؟ رسالة ربما
أتمنى أن يكون همنا الأول هو إخراج البقية، عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال، ما زالوا هناك في الجحيم. وما زالوا ينتظرون.
—————————
مجزرة التضامن ومحاسبة الأسد/ رضوان زيادة
مع كل جريمة يرتكبها الأسد يعود السؤال مجددا كيف يمكن ضمان تحقيق العدالة ومحاسبة الأسد على جرائمه المتكررة؟ أصبح السؤال يحمل كثيرا من النوايا السلبية المبطنة مع إدراك أن طريق العدالة يبدو مسدودا اليوم وربما سيكون ذلك في المستقبل أيضا.
إذ ليس هناك ولاية قضائية لمحكمة الجنايات الدولية طالما أن سوريا دولة غير موقعة ومصادقة على ميثاق روما الأساسي المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية، وليس هناك أي محكمة إقليمية على المستوى العربي لها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، فضلا عن فشل القضاء المحلي كليا في محاسبة عنصر أمن واحد على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين المدنيين.
ربما يعرف الأسد ذلك أكثر من غيره ويشعر معها بالحصانة الدولية فهو يستطيع القيام بما يشاء دون أن يكون هناك عقاب أو محاسبة على ما يفعل وهو ما يجعله يستقوي على السوريين بمزيد من القتل والتعذيب والاعتقال والقتل كما ظهر في فيديوهات مجزرة التضامن.
بالوقت نفسه لا يكترث النظام لكل البيانات الدولية أو لكل الإدانات الأممية والدولية أو تصريحات المسؤولين الغربيين فقد وضع نفسه في جدار من العزلة تكون أولويته الأولى والأخيرة هي البقاء في الحكم إلى الأبد مهما بلغ وضع السوريين من أسى وفقر، ومهما قتل وأباد عددا أكبر وأكبر من السوريين.
إنها للأسف مفارقة المجتمع الدولي والحاجة إلى تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية حيث من واجب المجتمع الدولي حماية السوريين من الأسد ومن استمراره في الحكم بما يعنيه ذلك مزيد من القتل والتعذيب والترويع بالسوريين وتحويل سوريا إلى دولة فاشلة تماما وظيفتها تصدير اللاجئين عبر العالم.
لقد أثبتت مجزرة التضامن مجدداً مسؤولية فشل المجتمع الدولي في محاسبة الأسد ونظامه على الجرائم التي ارتكبوها بحق السوريين، وفشل هذا المجتمع في مساعدة السوريين على الخروج من هذه المحنة التي لا تنتهي والتي يجد السوريون فيها أنفسهم يوما بعد بمزيد من الذل والتعذيب والقتل.
لقد ابتكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الآلية الدولية للمحاسبة لكن لم تظهر لها أي نتائج فعلية على الأرض إذ بقي عملها إلى اليوم محصورا في تجميع البيانات والأدلة والداتا دون الانتقال إلى تأسيس محكمة خاصة قادرة على محاسبة الأسد على جرائمه بحق السوريين وإنهاء هذه الفترة المظلمة من تاريخ سوريا.
وبالوقت نفسه عندما أسس مجلس حقوق الإنسان في جنيف اللجنة الدولية الخاصة بتقصي الحقائق في سوريا قبل عشر سنوات تقريبا لم يضع في عين اعتباره طول أمد النزاع وكيف سيتحول إلى صراع دولي على الأرض السورية، ولذلك من المهم إعادة التفكير اليوم في وظيفة هذه اللجنة اليوم حتى تستطيع لعب دور حقيقي في محاسبة الأسد وليس فقط توثيق جرائمه وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
لقد وضعت الأزمة السورية المجتمع الدولي مجددا أمام الفشل في تحقيق ما يسمى مبدأ “كيف لا ننسى” حيث أعادت جرائم الأسد التذكير بتاريخ طويل من المجازر من الهولوكست إلى جرائم حرب البلقان إلى جريمة الإبادة في روندا ودارفور وإلى كمبوديا وغيرها كلها تؤكد أن المجتمع الدولي فشل في إرساء نظام للعدالة يمنع مثل هذه الجرائم، وهو يدمر ثقة العالم بأن ما جرى في سوريا يمكن أن يحدث في أي بلد من العالم طالما أن هذا العالم تسامح مع استمرار مثل هذا النوع من الجرائم.
لقد أحدثت مجزرة التضامن ضجة دولية غير مسبوقة لكن يجب على العالم أن يحول هذا الغضب إلى سياسات تحاسب الأسد على جرائمه، وتفعل آليات عبر مجلس الأمن تضمن تطبيق القرار 2254 من أجل تحقيق الانتقال السياسي من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي يحترم السوريين ويضمن لهم العيش الكريم والرفاهية وليس القتل والتعذيب.
تلفزيون سوريا
——————————
حفرة التضامن تلغي المخططات/ د. يحيى العريضي
منذ أوجدها حافظ الأسد، بَنَت منظومة الاستبداد ذاتَها على المواجهة مع مَن تحكمهم؛ فهم بالضرورة أعداء، لا يستحقون العيش إلا كما تريد؛ بيدها كل شيء، حتى مصيرهم؛ تبرمجهم كما تشاء؛ تستعبدهم كما تريد؛ تذلهم ليكونوا عبيدها؛ ترفعهم ليخدموا أغراضها؛ تُفقرهم ليتبعوها. رغم ذلك قامت ثورة سورية. حاولت المنظومة قمعها بأبشع ما عندها من إجرام وإرهاب؛ صمدت رغم كل ذلك؛ وما من حسم للأمور، لأسباب يطول ذكرها.
بعد عقد ونيّف على الاستعصاء، التقط “نظام الأسد” وداعموه وسماسرة إعادة تكريره عبارة أمريكا بأنها تريد “تغيير سلوك النظام”، لا تغييره. نشأت على الفور خطة عمل، تجنَّد لها بعض العربان ترجمةً لشغفهم في التطبيع مع إسرائيل المربَكة تجاه مصير الأسدية حَرَس حدودها الشمالية؛ وتلبية لرغبتها، تعاونوا معها بوضع الخطة بالاشتراك مع روسيا، الساعي الأساسي لإعادة تأهيل منظومة الاستبداد؛ علّها تحصل على بعض الجنى السياسي والاقتصادي مكافأة لفعلها العسكري في سورية.
تكونت عناصر الخطة من:
– إصلاحات ومحاربة فساد، والابتعاد عن إيران، و الانخراط، حتى ولو شكلياً، بالعملية السياسية، و اتخاذ بعض إجراءات “بناء ثقة” تتعلق بالمعتقلين.
من جانبه، المبعوث الدولي لسورية، “بيدرسن” التقط فكرة ابتدعها أحد مراكز البحوث القريبة من الأسدية (وتحديداً مركز كارتر)، وهي “خُطوة بخُطوة”، لتكون الإطار العامّ لإعادة التأهيل. سعى بيدرسن بدعم دولي لتسويق تلك البدعة، التي تظاهر “نظام الأسد” بعدم قبولها؛ ولكنه سارع للقيام بـ”الخُطوات” التي طُلِبت منه أعلاه:
– في “الإصلاحات ومكافحة الفساد” بدأ التضييق على أزلامه ومديري سرقاته لموارد سورية، وسحب منهم ملايين الدولارات، وكثّف آلة الدعاية والكذب بأن الحال سيكون أفضل؛ فزاد منسوب الإفقار والعوز والإذلال؛ ليصل مَن تبقى تحت سلطته من سوريين إلى قبول أي طريق لتخفيف الجحيم. أصدر جملة من القوانين والمراسيم في توسيع وبعثرة وإعادة تكريرٍ وقحٍ لقانون العقوبات مُجهِضاً أي محاولةٍ سوريّةٍ للادّعاء عليه، حامياً لمجرميه ومفسديه.
– وفي الابتعاد عن إيران، لا بد من تدبُّر إخراج المسرحية مع إيران ذاتها، بحيث تتظاهر إيران بميلها لذلك التقارب عارفة بالعمق استحالته؛ فأطلق مسؤولوها بعض تصريحات الترحيب بالتقارب مع المحيط العربي، وفي الوقت ذاته نقرأ في (قناة المنار) خبراً مفاده “محاولة لاغتيال الأسد” في “صلاة العيد”، ثم سحبته فوراً، للتظاهر بعدم ارتياحها للفصل بينهما. ومن جانبه، اشترط اقتراباً عربياً منه، ورفعاً للعقوبات الاقتصادية والمقاطعات، لتلبية طلب التباعُد عنها.
– وفي العملية السياسية استند إلى مَن هو جاهز، ولعابه يسيل للذهاب لاجتماعات الدستورية؛ حتى ولو كانت وهماً وسراباً. حتى قَبْلَ دعوة بيدرسن، كانت بعض “المعارضة” جاهزة للذهاب، وإثر إرسال الدعوة قبِلتْها فوراً ودون الرجوع لأحد.
– وفي الإجراءات “الإصلاحية”، أصدرت المنظومة جملة من القوانين حول “تجريم التعذيب”، وانتقاد “هيبة الدولة”، وأي “إساءة للدين”، أو “الدعوة للانفصال”، أو محاولة “الانقلاب على السلطة”، و”الجرائم الإلكترونية”؛ والغاية تحصين مجرميه وحماية مفسديه.
وما أن أضحت هذه الخطوات ملموسة، على الأقل إعلامياً، حتى انفجرت في وجه منظومة الاستبداد حفرة التضامن، كاشفةً واحدةً من آلاف المجازر التي ارتكبها؛ وخاصة أن مَن وراء الكشف صحيفة “الغارديان” البريطانية ذات السمعة العالمية، والتي كان صداها أكبر مما لو جاءت على لسان النيويورك تايمز أو الـ CNN؛ فما كان من منظومة الاستبداد إلا أن فتحت على عجل ورقة المعتقلين الأداة التي تأخذ بها السوريين والعالم رهينة.
لسوء طالع منظومة الاستبداد، كان تبلوُر تلك الإجراءات يتم قبل وإبّان الغزو الروسي لأوكرانيا، ووقوف تلك المنظومة مختارة أو مُجبَرة مع إجرام بوتين. وكان لذلك تأثير على الخطة المرسومة. لقد أتت في وقتٍ، والعالم يعمل على خنق روسيا وردع عدوانها على أوكرانيا؛ وما فعله الأسد تجاه الغزو لا يفعله إلا معلولٌ عقليٌّ، أو مطعونٌ أخلاقياً، أو انتحاريٌ. وتستمر روسيا ببهلوانيتها، ومكابرتها، وممارسة انفصامها، متجاهلةً سعيَ العالم لقطع أذرعها، وتغيبها عن ساحة السياسة الدولية؛ فكانت تلك الصفعة الأولى للخطة. ثم كانت الصفعة الثانية والأقوى تكشُّف حفرة التضامن؛ وها هي تأتيها الصفعة الثالثة بدعوة أمريكا مجلس الأمن لاجتماعات ثلاثة هذا الشهر حول سورية لإعادة فتح الملفات الإنسانية والكيماوية والسياسية.
ثم تأتي الصفعة الأقوى المتمثِّلة بمهزلة “العفو العامّ”، التي كانت بمثابة فضيحة حقيقية. فعندما يخرج من مقابر أحياء منظومة الاستبداد شباب بلا ذاكرة أو عقل، وآلاف من زملائهم غادروا عالمنا تحت تعذيب وحوش لا علاقة لهم بالإنسانية تصبح الفضيحة مدويّة؛ ويبتلع إعلام المنظومة وأبواقها ألسنتهم والتشدق بأن “الرئيس” أصدر مرسوم “عفو عامّ” عن المعتقلين.
والشاهد الموجع كان تلك القلوب والخواطر الكسيرة لعشرات آلاف السوريين ينتظرون بصيص أمل لرؤية مُغيَّب عنهم أو مفقود، للخروج من مقابر الأحياء في معتقل صيدنايا وغيره؛ ليُصابوا ثانية بكسر قلب وخاطر جديد وإذلال وإهانة بالانتظار لساعات طوال في الشوارع وتحت الجسور.
سيلاحق السوريون منظومة الاستبداد إلى يوم القيامة؛ فمَن قُتل ولده، أو اغتُصِبت ابنته، أو أُذِلَّ لأبسط الحاجات، أو دُمِّر سكنه، أو قضى مَن يحب ببرميل أو سلاح كيماوي، أو سلّطت عليه المنظومة “داعش”، أو عَرَفَ عمالة المنظومة لإسرائيل ودعوتها للاحتلال الروسي والإيراني؛ لن ينسى ولن يغفر، وسيلاحق المنظومة إلى أن يراها في حال أسوأ من حاله، حتى ولو حمتها قُوى الأرض.
رغم أنف إسرائيل، الحامي الأساسي للمنظومة؛ ورغم البراميل؛ ورغم التعذيب الذي أتى على أرواح عشرات آلاف السوريين في المعتقلات؛ ورغم سوخوي بوتين، و”أستانا” الجديدة، ورخاوة أمريكا، ونذالة بعض الأنظمة العربية؛ ورغم عمائم النفاق في صلاة عيد الفطر؛ ورغم عشق البعض لوظيفة “معارضة”، وإصرارهم على منح الوقت والشرعية لمنظومة الاستبداد الأسدية بالحرص على مهزلة “الدستورية”؛ فإن حفرة التضامن تلغي كل المخططات، وهي بالانتظار، وسيأخذ السوريون حقهم ويتخلصون من الوباء الأسدي، طال الزمام أم قَصُر.
———————–
===================
تحديث 11 أيار 2022
————————–
الهولوكوست السوري 2013 تحت إمضاء الأسد/ فاضل المناصفة
حرك تقرير الغارديان الأخير حول الهولوكوست البعثي في حي التضامن بدمشق مشاعر الملايين من البشر الذين تأثروا بالفيديو الموثق لإعدام جماعي لمجموعة من الأشخاص، ووصف المشهد بتفاصيله المروعة مدى وحشية نظام الأسد الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء من أجل الحفاظ على ملكيته لسوريا وإن اقتضى الأمر إحراق الحجر والبشر والشجر.
قد يكون الفيديو الصادم الذي كشف تفاصيل جريمة شيطانية في سنة 2013 الشجرة التي تخفي غابة كبيرة من الجرائم المماثلة، كما أعاد إلى الأذهان الحرب السورية بكل حيثياتها، بعد أن تساقطت جرائم الأسد بالتقادم وأفلت من عقاب محكمة الجنايات الدولية، وبعد أن أصبحت سوريا قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى جامعة الدول العربية، الأمر الذي بعث الشكوك حول توقيت نشر التقرير وعلاقته بالتطورات الحاصلة في الشرق الأوسط، وكأن هناك جهة تريد تصفية حساباتها مع “المملكة” السورية قبل أن تتطور الأحداث وتميل في كفة الأسد، الذي يقترب يوما بعد يوم من الخروج من العزلة الإقليمية بشكل رسمي.
لقد حبس الفيديو الصادم أنفاس الملايين من السوريين الذين يواجهون خطر العودة إلى “مملكة” الأسد التي لا يُرحم فيها أحد، كما فتح الباب واسعا أمام العديد من التساؤلات حول مصير العديد من حالات الاختفاء القسري وعدد المقابر الجماعية التي أحصتها الحرب، وعن إفلات المجرمين التابعين لميليشيا الأسد الدموية من العقاب، وقيمة المكافآت التي تعهد لهم النظام بتقديمها على حسب الكم والنوع من الوحشية كبرهان ولائهم للمنظومة الفاسدة التي دمرت كل شيء من أجل أن تستمر في السيطرة على دولة نهشها الفساد نهشا، حتى انفجر سكانها في وجه حزب البعث في ثورة عفوية اعتبرها النظام خروجا عن الحاكم استحق فيها المطالبون بالحرية التصفية والتهجير والإبادة الجماعية في أخطر بقعة على وجه الأرض بعد كوريا الشمالية.
لم يترك نظام الأسد وسيلة إبادة إلا واستعملها ضد شعبه، ولم يدع أي مجال لتصديق روايته التي تحدثت مرارا وتكرارا عن مؤامرة كونية أحيكت لإسقاط سوريا وسميت بالربيع العربي، كما لم يترك أي فرصة تسمح له بالدفاع عن أحقيته في حكم سوريا، لقد ترك أبناء البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار في الشتات والمعاناة من الغربة أو العودة وتسليم الرقاب في يد نظام أقل ما يقال عنه أنه دموي بامتياز، وله تاريخ حافل بالجرائم ومتوارث من الأب الذي كان مسؤولا عن مجزرتي حلب في 1980 وحماة في 1982 اللتين كانت دوافعهما زرع منظومة الرعب في نفوس السوريين لكي لا تسول لهم أنفسهم في التفكير بالحرية أو قلب نظام الحكم، وما أن جاء الربيع العربي زال مفعول المجازر واستدعى هذا من الأسد أن يعيد الكرة للحفاظ على ملك أبيه.
إن تقرير الغارديان البريطانية يستدعي فتح دفاتر الماضي والتحقيق مجددا في عمليات الإعدام الجماعي التي حصلت، وربما تستمر في الحصول، بعيدا عن عدسات الكاميرا بعد أن أصبح الملف السوري لا يستهوي الإعلام الغربي، وبعد أن أعاد النظام السوري بعث نفسه وأصبح من الصعب جدا الحصول على تقارير ميدانية قوية من الداخل السوري، خاصة وأن أجهزة المخابرات السورية أصبحت تعمل تحت إشراف روسيا.
لقد نجح التقرير إلى حد ما في تذكيرنا بالثورة السورية والتأكيد على أن نظام الأسد لا يستحق أن يعامل كدولة وإنما كمنظمة إرهابية شأنها شأن داعش وبوكو حرام، ولكن التقرير ضاعف المخاوف حول المصير المجهول الذي سيواجه عشرات الآلاف من السوريين بعد عودتهم إلى الوطن الذي اغتصبته عائلة الأسد، وهو ما عبر عنه الآلاف من السوريين المغتربين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما وضع التقرير العديد من الدول المستضيفة للسوريين في إحراج كبير: إما إطالة مدة إقامة السوريين وتحمل العبء، أو تسليمهم لمصير مجهول في ظل عدم توفر أي ضمانات من دمشق بعدم متابعة المعارضين وتعريض حياتهم للخطر وإن كنت أجزم بأن الأسد لا يرغب في عودة أحد ما دام السوريون في الداخل عبئا على مملكته في الأساس التي لن تستطيع أن توفر لهم ربطة خبز أو أسطوانة غاز.
العرب
—————————-
عن استثنائية “عفو” الأسد الأخير/ منار الرشواني
لم يكن الرأي باستثنائية “العفو” العام الذي نص عليه المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، والصادر في 30 نيسان/أبريل الماضي، مقتصراً على نظام بشار الأسد، حين عدته رئيسة محكمة الإرهاب زاهرة بشماني من “أوسع مراسيم العفو”، كونه “شمل كل الجرائم والأفعال الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 سواء فيما يتعلق بالعقوبة المقيدة للحرية أو العقوبة المالية”.
ومن ثم، بدا طبيعياً البحث عن الأسباب الحقيقية لعفو كهذا “غير مسبوق” بوصف المحامي السوري عارف الشعال، بعيداً عن “كليشيهات” النظام الذي برر العفو، كما جاء على لسان معاون وزير العدل في حكومة الأسد، نزار صدقني، بـ”الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وتحريره لمعظم الأراضي السورية من دنس الإرهاب لذلك عفت الدولة ووجهت دعوة مصالحة لأبنائها الذين تورطوا بجرائم إرهابية للاستفادة من المرسوم والعودة لحياتهم الطبيعية”.
هكذا، قُدمت على الجانب المقابل تفسيرات مختلفة تماماً بشأن دوافع ما يسمى “عفواً”. أولها وأكثرها انتشاراً محاولة النظام احتواء تداعيات افتضاح مجزرة حي التضامن بريف دمشق، بالصوت والصورة، قبل أيام من صدور العفو، كما لخص ذلك وسم (هاشتاغ) “العفو عند المجزرة” على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين يأخذ تفسير آخر بالتغيرات الدولية والإقليمية، لا سيما انعكاسات التورط الروسي الذي يبدو أنه سيكون طويلاً في أوكرانيا، وعدم اليقين بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، أو ارتدادات اتفاق كهذا حتى في حال حصوله على استقرار نظام الأسد.
ورغم أن التفسيرات الأخيرة تصدر عن مناوئي الأسد، فإنها تنطوي على افتراض ضمني أساسي، جوهره أن النظام بما يسمّيه “عفواً” عن “إرهابيين” إنما يقرر العودة إلى الشعب السوري، استرضاء أو احتواء، لتدارك تداعيات واحدة من مجازره أو تصليب موقفه في مواجهة التغيرات الدولية المحتملة.
لكن عملية الإفراج عن المعتقلين، وأعدادهم، وتاريخ اعتقال عدد منهم، وحتى الجرائم المنسوبة إليهم أو المدانين بها، تُظهر أن هدف النظام أبعد ما يكون عن محاولة استمالة الشعب السوري بأي شكل كان، وإنما العكس تماماً. وهو ما يستتبع بالضرورة العودة إلى البحث عن أسباب أخرى للعفو تتفق مع حقيقة هذا النظام، بكونها تهدف حتماً إلى ضمان بقائه، لكن، وكما دائماً، على حساب حقوق الشعب السوري ككل.
تقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس الماضي بـ132,667 شخصاً. في المقابل، لا يزال عدد المفرج عنهم في حدود بضع مئات. والخشية أن لا يكون العدد النهائي أكبر من ذلك بكثير. هكذا، يبدو المردود الوحيد المؤكد حتى الآن لما يسميه الأسد “عفواً” ليس سوى تفجير مآس مكبوتة إلى العلن، تلخصها جموع السوريين المحتشدين أملاً في أن يكون أبناؤهم وأحبتهم بين العدد القليل جداً من المفرج عنهم. ولعل أكثر ما يلخص هنا مأساة العيش في سوريا الأسد ما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود أمهات بين المترقبين يمتلكن شهادات وفاة لأبنائهن، لكنهن مع ذلك يأتين على أمل أن يكون أبناؤهن من بين المطلق سراحهم؛ ففي سوريا الأسد لا الأحياء أحياء فعلاً، ولا الأموات أموات بالضرورة.
هل أراد النظام فعلاً إذلال السوريين وقهرهم حتى بالأمل؟ لا يبدو ذلك مستبعداً أبداً. فرئيسة محكمة الإرهاب التي تصف بـ”ضعاف النفوس” مروجي الأخبار عن وجود قوائم تتضمن أسماء المفرج عنهم، تعود لتشدد أن نظامها لن يصدر قوائم كهذه، تاركاً الناس نهبَ أملهم ولهفتهم وأخيراً قهرهم. أيضاً، يبدو لافتاً غضّ النظام عن التجمع تحت جسر الرئيس بدمشق بانتظار أحبتهم، في حين لا يتصوّر غالباً السماح لأعداد أقل من ذلك بكثير بالتجمهر هناك في ظروف أخرى، خشية تحوّل التجمع إلى تظاهرة. فهل كان غضّ الطرف هذا مقصوداً لإظهار انتصار النظام في قهر السوريين بحيث ما عادوا قادرين على الاحتجاج حتى في مواقف قاسية كهذه؟
ربما أراد النظام كل ذلك، وربما جاء نتيجة غير مقصودة، إنما مرحّب بها، لدوافعه الحقيقية لإصدار العفو. ويبقى، من باب التخمين أيضاً، أنه إذا كان للعفو الأخير دوافع إقليمية، فهي لا تتجاوز توفير الأسد غطاء هزيلاً، وإجرامياً في الوقت ذاته، لحلفائه (الجدد خصوصاً) للمضيّ قدماً في تعويمه إقليمياً ودولياً. أما المؤكد فهو أنه لم يكن يريد التغطية على مجزرة التضامن، بل تعزيز تبعاتها بتعميق الاستقطاب الطائفي، عبر ضمان تماسك حلقة الكراهية والخوف المفرّغة التي يدور فيها السوريون. فهكذا فقط نجا النظام وينجو. وهذا فقط ما يجعل من عفو الأسد الأخير استئنائياً فعلاً.
تلفزيون سوريا
————————–
سوريا وأهلها: ألم بجرعات زائدة/ مصطفى ديب
في غضون أسبوعٍ، أو أقل، وجد السوريون أنفسهم أمام أحداثٍ عصيةٍ على الفهم لشدة فظاعتها، وقسوة ما ترتب عليها من ألمٍ لم يكن بوسعنا، أو بوسع بعضنا على الأقل، فهمه والتعامل معه. ألمٌ يضاف إلى آلامٍ أخرى ظننا أننا أصبحنا، بعد عيشها والعيش في ظلها لأكثر من عقد، مؤهلين للتعامل مع ما يستجد منها. فالافتراض هنا أن اختبار الألم يمنحنا القدرة على استيعاب المزيد منه.
لم يكن بوسع هذه الفرضية أن تصمد أمام أهوال مجزرة حي التضامن، وقسوة مشاهد انتظار مئات السوريين للمعتقلين الذين أفرج عنهم جزّار سوريا، مؤخرًا، على أمل أن يكون أباؤهم وأبناؤهم، أو أحد أقاربهم وأصدقائهم، بين هؤلاء الذين انتظرهم البعض لعلهم يجدون لديهم خبرًا عن غائبٍ ما، حدث أن صادفه أحدهم في مسالخ النظام. فالألم الذي ترتب على هاتين الحادثين بدا، لسببٍ أو لآخر، فريدًا في قسوته بالنسبة إلى شعبٍ عاش سنواته العشر الأخيرة، ولا يزال، محاطًا بمختلف أشكال الألم والقسوة.
وفي ضوء انشغال السوريين بمجزرة حي التضامن، والمشاهد المأساوية القادمة من دمشق لمعتقلين نجا بعضهم من سجون النظام، لا من آثارها، وخرج بعضهم الآخر منها فاقدًا للذاكرة، تحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال افتتاح وزير داخليته سليمان صويلو قرى سكنية من الطوب لتحل محل المخيمات المنتشرة على عرض ما تبقى من مناطق محررة، عن خطة لإعادة نحو مليون لاجئٍ سوريٍ، طوعًا، إلى المناطق الآمنة في شمال سوريا. ولا حاجة إلى التذكير هنا بأن هذين المصطلحين؛ “طوعًا” و”آمنة”، لا يحيلان في سياقنا هذا إلى غير نقيضهما.
تثير خطة أردوغان أسئلة مختلفة حول مستقبل اللاجئين السوريين في بلاده وغيرها من دول اللجوء الأخرى، وخاصةً في لبنان التي لا تقل أوضاعهم فيه سوءًا عما هي عليه في تركيا، التي تشهد تصاعدًا مخيفًا في خطاب الكراهية والممارسات العنصرية بحقهم على خلفية اقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية فيها. كما أنها تشير أيضًا، في الوقت نفسه، إلى عدم وجود حلولٍ قريبة تضمن عودتهم إلى مدنهم وقراهم، مقابل أخرى ترجّح إعادة بعضهم إلى المناطق المحررة التي تضيق أصلًا بملايين النازحين، الذين توحي خطة أردوغان بأن إقامتهم في المخيمات، بصرف النظر عن شكلها، لا تزال طويلة.
ومع ذلك، يرى البعض، وهم كثر، بأن إقامتهم هذه تبقى أمرًا مؤقتًا، بالمعنى القريب طبعًا، حتى وإن تبدل شكلها وتغيرت مسمياتها أيضًا. الأحرى أن هذا ما يوهمهم به الأمل الذي دلت الأحداث السابقة، كل بطريقتها، على أن حياتنا، أو حياة بعضنا على الأقل، تقوم عليه وعلى فكرة أن كل ما نعيشه إنما هو مؤقت.
بل أكثر من ذلك، أن حياتنا ما بعد آذار/ مارس 2011 هي، بأكملها، مؤقتة. اللجوء والنزوح هما مؤقتان أيضًا، ومعهما الحرب وبقاء النظام وإفلاته من العقاب على جرائمه، وكذا غياب المعتقلين الذي يتعامل بعضنا معه على أنه شأنٌ مؤقت، والدليل هو الحشود التي تجمهرت في دمشق تنتظر من أوهمهم الأمل بأنهم عائدون لا محالة، ذلك أن غيابهم لا بد أن يكون مؤقتًا بدوره.
وما يقال عن اللجوء والحرب وبقاء النظام وجرائمه والمعتقلين أيضًا، يقال عن مختلف تفاصيل حياة السوريين خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً المهجّرين منهم. فعلى سبيل المثال، يتشارك السوريون في المنطقة التي أعيش فيها، على اختلافهم واختلاف أوضاعهم المادية، قناعة راسخة مفادها أن عودتهم قريبة بما يكفي ليكون الاستقرار ضربًا من ضروب العبث، وأمرًا لا طائل منه.
وبما يكفي أيضًا لتكون حياتهم، بمختلف تفاصيلها، مؤقتة سواءً لناحية المسكن والأثاث وطبيعة الحياة ذاتها ونمط العيش، الذي يوحي بأنهم على وشك العودة. أو هذا ما يقوله الأمل الذي يحول بيننا وبين عيش حياةٍ طبيعية مستقرة، حتى وإن لفترة مؤقتة. فالاستقرار هنا يتعارض مع ما يمليه الأمل عليهم، ويقلل من شأنه، وينفي أن تكون حياتهم، في اعتقادهم، مؤقتة بالمعنى الذي يحيل إلى عودة قريبة، بل قريبة جدًا.
لا يسمح لنا الأمل إذًا بمواصلة حياتنا بشكلٍ طبيعي، فما يوهمنا به الأمل هنا أن حياتنا ذاتها توقفت، مؤقتًا، مع بداية الحرب وما ترتب عليها من تهجيرٍ ونزوح، وأنها ستُستأنف بعد نهايتها. وهذا بالضبط ما يفسر رفض البعض عيش حياةٍ مستقرة لا يرى فيها ما يراه في تلك المؤقتة التي تجعله قريبًا من العودة، تمامًا كما لو أنها ستحدث غدًا. وبينما يحدث هذا كله، تمضي الحياة غير مبالية بما نشعر، ونعتقد، ونتوهم.
لذلك جاءت الأحداث الأخيرة لتضعنا أمام حقيقة أن ما نظنه مؤقتًا سيبقى كذلك، لكننا لا نعرف إلى متى. استبدال الخيمة ببيتٍ من الطوب، بدلًا من إعادة اللاجئين إلى بيوتهم، يوحي بذلك. وكذا الحديث عن إعادة نحو مليون لاجئٍ سوريٍ من تركيا إلى المناطق التي يزعم البعض أنها آمنة. وخروج بعض المعتقلين فاقدين للذاكرة مؤخرًا، يفعل الأمر نفسه، بل ويضعنا أيضًا أمام ما يرفضه بعضنا، وهو أن لا شيء سيعود إلى سابق عهده بعد انتهاء الحرب، لا الناس ولا البيوت.. ولا حتى أعمارنا.
الترا صوت
—————————–
=================
تحديث 12 ايار 2022
———————-
نهاية «التضامن»: العلويون شبيحة والسنّة إرهابيون؟/ حسام الدين محمد
فتح تقرير الباحثين أور أوميت أونغر وأنصار شحود حول مجازر حي «التضامن» التي جرت في نيسان/إبريل 2013، وشريط إحدى هذه المجازر الذي بثته صحيفة «الغارديان»، باب السجال حول طبيعة العلاقة الطائفية بين المنظومات السياسية في سوريا، وارتباط ذلك بعمليات الإبادة الجماعية التي أظهرت المجزرة الأخيرة، تحوّلها إلى صناعة احترافية، من جهة، وإلى شكل من أشكال التسلية المرعبة، عبر خطف وإعدام وحرق أشخاص عاديين ليسوا متورطين في الصراع، ولكنّهم سوريون (وفلسطينيون) تم التقاطهم على حاجز أمني.
أججت تداعيات المجزرة الجدل المستعرّ حول علاقة الطائفة العلوية بالنظام، عبر تحميل مسؤولية المجزرة لثقافة حاكمة ضمن تلك الطائفة، واعتبار الحكم الحالي طائفيا، واستقبل هذا الطرح، من معارضين من أصول طائفية متعددة، بمقارنات تدور حول علاقة التنظيمات الجهادية المتطرفة، خصوصا تنظيم «الدولة الإسلامية» (المعروف بداعش)، بالحاضنة السنّية.
لخّص السوري محمد صالح، الجدل بالقول: «كل السنة بيئة حاضنة للدواعش مع تسليط الضوء على عمل الدواعش الوحشي. كل العلوية شبيحة للنظام القائم مع تسليط الضوء على الأعمال الوحشية للشبيحة»، بمعنى أنه عندما يحصل عمل وحشيّ من «الشبيحة» العلويين، يصبح العلويون في نظر خصومهم شبيحة كلهم، وعندما يحصل عمل وحشي من «الدواعش»، يصبح السنّة كلهم، في رأي خصومهم، دواعش. لكن السؤال هو، هل يحصل هذا التعميم عند ظهور أعمال وحشيّة؟ أم أنه تعميم غالب على رأي السنّة، في عمومهم، في العلويين، ورأي العلويين، في عمومهم، في السنّة، وكيف تظهّرت هذه الأفكار في سجالات السوريين؟
«ثقافة الأغلبية» سبب نشوء الاستبداد؟
يعرض الكاتب السوري سمير سليمان، عدة مقاربات للمسألة، فيتحدث عن مصادفته كثيرين كانوا مثل أمجد يوسف، «ينتظرون الفرصة لإثبات وجودهم «بقتل آخرين مختلفين وضعفاء»، بمن فيهم «أمهات نذرن أولادهن لقتل آخرين»، معتبرا إياهم «الحثالة التي رأت في مناخ الثورة فرصتها في التماهي مع روح الإبادة التي أعلنها نظام الأسد ضد السوريين»، ومستنتجا أن القاتل «نموذج لشريحة واسعة تعيش بيننا منذ نصف قرن»، وأن أمثاله موجودون بين معارضي النظام أيضا.
يوضح سليمان، لاحقا، أن يوسف، «لم يرتكب مجزرته لأنه علوي، رغم أن «علويته» لا تنفصل عن جريمته، والداعشي النمطي، لا يرتكب جريمته لأنه سني رغم أن «سنيّته» لا تنفصل عن جريمته»، فالانتماء الطائفي لا يشكل بمفرده سببا لارتكاب الجريمة، وإلا لصار كل علوي أو سنّي قاتلا «عندما تسنح له الفرصة»، لكن سليمان، كتب في رأي لاحق، أن الأقليات السياسية، كالعلوية والدرزية والمارونية «وكل أشكال العشائرية السياسية، إنما خلقت على أرضية السنية السياسية وحاجتها إلى تسييس الطوائف».
يجري في هذا الطروحات تأرجح بين الفرضية السياسية – الاجتماعية التي تربط الأحداث ذات الطبيعة الثقافية (الطائفية، المذهبية، العشائرية إلخ) بحيثيّات الواقع السياسي والاجتماعي (وهو في الحالة السورية، نشوء نظام استبداديّ)، والفرضية الشائعة الأخرى، التي تحيل الوقائع السياسية – الاجتماعية إلى الثقافة (تحت مسميات مثل «الإسلام السياسي» أو «ثقافة الأغلبية»)، بحيث تكون ثقافة الأقليات الطائفية (والاستبداد؟) رد فعل على ثقافة الأغلبية.
في المقابل، يرى الكاتب السوري محمد منصور، أن من يقارنون بين النظام و»الدولة الإسلامية» يشبّهون «ما يفترض أنه حكم دولة لها ممثل في الأمم المتحدة، بحكم تنظيم مارق لا وطن له، ولا قيمة قانونية لسلطته»، وهو ما يعتبره اعترافا بأن «السلطة العلوية التي أسسها حافظ الأسد ليست حكم دولة» وأنها في جوهرها «تنظيم طائفي إرهابي استولى على الدولة واستمر بالحكم بالقوة وأقام سلطته بالقتل والمجازر ونشر الإرهاب»، وبالتالي «فلا سبيل للدفاع عن جرائمه إلا بمقارنته بأفعال تنظيم إرهابي مثله».
من ضابط أمن إلى متصوّف زاهد
يؤكد منصور إن هدف المجازر هو «البقاء في السلطة»، لكنه يرى أن شكل البقاء في السلطة الذي يريده النظام هو طائفي: «يريدونها سلطة طائفة يضعها النظام وتضع نفسها فوق كل المكونات الأخرى في الامتيازات والوظائف والبعثات والوساطات و»حق» ارتكاب الجرائم»، وإن الطائفة «لا تريد أن تتعايش مع أي مكون آخر إلا اذا كان لها الغلبة والسيطرة على أجهزة الأمن والجيش والقضاء والإعلام والسفارات وسلاح الطيران والبراميل والكيميائي»، لكنه يؤكد أن الحل «ليس القتل والانتقام وممارسة السلوك الذي سلكه المجرمون»، وأنه «يبدأ بتشخيص المرض كما هو».
يظهر محمد تركي الربيعو، تعقيد هذه الرابطة بين العلويين والسلطة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تفسيرها في سياقات ثقافية وحسب لأن «الترابط الهوياتي لم يكن ناجما عن خوف طائفي، بل أيضا عن ظهور محفزات جديدة للتماسك»، وأن ما يحكم «الترابط والاستقرار» في النهاية بين الطرفين «هي الآليات التنظيمية والأيديولوجية لأجهزة الدولة القائمة»، كما يشير إلى منظومات رمزية تنشأ وتقوم بتغذية خطاب الانقسام الهوياتي (كوضع صور القتلى على القبور وتحويل المقابر لمزارات يحج الناس لها)، كما تؤثر في هذا العالم القرابة والانتماء لمؤسسات السلطة وظروف القتال اليومي وسقوط قتلى، بحيث تتحول «العوامل الأيديولوجية آلية قوية للغاية بمقدورها أن تتحول بسرعة إلى أيديولوجية عدائية وفتاكة»، منبها، في هذا الخصول، إلى مجازر ارتكبتها تنظيمات سلفية سنية ضد علويين.
تقول رشا عمران، إن عائلة أمجد يوسف «اختلط لديها مفهوم الوطن بالطائفة»، وأن أسرا كثيرة مشابهة لأسرة يوسف وآباء مثل أبيه «تحولوا بعد انتهاء خدمتهم العسكرية والأمنية إلى رجال دين لطوائفهم أو زهادا أو متصوفة»، «يعيشون حياتهم كما لو أنهم لم يفعلوا شيئا، إذ هذا أيضا شأن باطني، لم يكن يسمح بالحديث عنه». يرد الوصف الآنف في معرض الاستنكار، لكنّه، يشير، من جهة أخرى، إلى نمط آخر من التحوّل، ينتقل فيه ضابط الجيش والأمن العلوي، من الخدمة العسكرية – الأمنية (ومستتبعاتها القمعية)، إلى الدينيّ الرمزيّ وحتى الصوفيّ (وبالعكس طبعا).
يلاحظ في مجمل سجالات السوريين حول علاقة النظام السياسي القائم بالطائفية اختلافا عن أقرانهم في بلدان أخرى، فالموضوع ما زال أقرب للمحرّمات، والخوض فيه يؤدي، تلقائيا إلى ارتفاع منسوب التوتّر والاتهامات.
أحد أسباب هذا التوتّر بين المثقفين السوريين، وهذا الحرج من فتح هذا السجال بطرق سياسية واضحة، في اعتقادي، وجود تقليد سوري، كرسته السلطات، التي تعمل على تأكيد الطائفية في الواقع المعاش، وحظرها، في الوقت نفسه، من النقاش الصريح بعنف، على عكس حالة سلطات أخرى ونخب أخرى.
تطييف السياسة الهائل في سوريا يتم مع شغل لا يقل هولا لإنكاره وتقنيعه وتصريفه بمصطلحات أخرى، من الوحدة والاشتراكية المأسوف على شبابهما، وصولا إلى أحاديث السيادة والممانعة ومواجهة الإمبريالية.
في الوقت الذي يحظر الحديث عن استحكام الطائفية في سوريا، تتحدث فيه مستشارة للأسد عن «خطف أطفال علويين» وتعريضهم للإبادة في الهجوم على الغوطة (المنطقة السنية المعارضة)، ويتحدث وزير خارجية راحل عن الهجوم على جوبر والغوطة (السنيتين) لحماية جرمانا وباب توما (الدرزية والمسيحية)، أما في الحالة الإسرائيلية، فتشتغل الأحزاب السياسية على إعلان «يهودية الدولة»، ولا يجد محازبو «حزب الله» وحركة «أمل» في لبنان شعارا سياسيا يرفعونه علنا غير «شيعة شيعة»، أما في سوريا، فتجري المجازر تحت راية «الوحدة الوطنية»، وبعد اكتشاف المجزرة، لا يرى أنصار النظام حرجا في إعلان مرتكبها «بطلا وطنيا».
كاتب من أسرة «القدس العربي»
القدس العربي
———————
ليست الحرب بل هي الجريمة/ علي سفر
يستدعي استخدام مقولة “إنها الحرب” في الحديث عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مراجعة وتدقيقاً، في إمكانية أن تتحول إلى معطفٍ، يحلو للبعض أن يحشو تحته ما يريد، وفي أي وقت يريد!
كما أنها تقود للبحث في خلفيات من يرى أنها كإطار تصلح للحديث عن كل ما جرى ويجري في حرب بلا ملامح، بينما هي في الواقع حرب النظام على الثائرين ضده.
لقد وضعت البشرية القواعد والقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية الأساسية من عتبة ملحة، هي تجنيب البشر وقوع الظلم عليهم، وتفضيل الحلول السلمية، ومنع أي جهة، من أن تستخدم القوة من أجل تنفيذ خططها.
كل ما حرر في هذا الاتجاه، لم يكن أعور، بل كان يبصر إمكانية حدوث خرق لكل ما تتفق عليه الأمم والحكومات والقيادات، ولهذا تم وضع الروادع، ليس للظروف العادية فقط، بل حتى للأوقات الاستثنائية، إذ لا يمكن اعتبار المعارك فرصة مرخصة، لعودة البشر إلى الحالة البهيمية، وترك الجنود يتحاربون كما لو أنهم حيوانات في غابة!
لا يحتاج المرء لأن يكون حقوقياً لكي يميز، فالمبادئ العامة والشرائع التي تتكرر يومياً في حياتنا، تجعل أي شخص يدرك بأن وقوع الحرب لا يعني الانفلات على البشر، وارتكاب الجرائم بحقهم، خاصة إن كانوا غير مشاركين فيها، ولا يحملون السلاح، وأن على القادة أن يمنعوا حصول مثل هذه الحوادث، وإلا كان من الواجب على دول العالم أن تتدخل لمنع وقوع هذا، وسوق من ارتكبوا المجازر إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالما أننا لا نستطيع محاسبتهم في المحاكم الوطنية.
أتحدث هنا عن السياق العام، ولكن ما أريد الوصول إليه، هو أمرٌ سوري، يتعلق بقراءة متقاعسة كسولة للمقولة المذكورة أعلاه، لا تريد أن تبذل جهداً لترى خطورة استخدامها، وهنا نحاول فهم الأمر من بوابة النوايا الحسنة، فلا نجرم أصحابها، طالما أنهم لا يدفعون باتجاه حماية جهة ما.
وأيضاً يتصل بقراءة خبيثة، تستخدم هذه العبارة وغيرها، لتبرر صمتها عما حدث ويحدث، ولكي تخفي سعيها الحثيث إلى دعم النظام الأسدي، إما عبر الإنكار وهذا ما يفعله مثقفوه دائماً، وإما عبر توزيع الجريمة عليه وعلى غيره، فعندما تذكر جرائم القتل المرتكبة على يد جنوده وعناصره، سرعان ما ترد عبارة تسأل: وهل هو القاتل الوحيد؟ وكذلك القول: “الكل مثل بعضهم” كأن تعميم الأفعال الخسيسة على كل الجهات المتورطة في الحدث، يعفيها من تبعات ما فعلت، ويمنع محاسبتها!
لا يمكن للعبارات، ولا حتى لأهم المقولات، أن تعفي مجرماً من جرمه، لأنها مجرد تفسير، وليست قاعدة حقوقية، وهي فعلياً أقوال لا تمتلك سلطة على البشر وحقوقهم، فإذا وقعت جريمة ما، لا يمكن لعبارة مثل “إنها الفوضى” أو “لقد غاب القانون” أن تبرر لمرتكب من أتى به!
وأيضاً يمكن ملاحظة أن مثل هذه العبارات، تتناسى حقوق الضحايا، الذين يغيبون، ولا يظهرون حتى بين الحروف أو السطور! وقبل هذا كله، ألا يُلاحظ أن تكوين عبارات كهذه يقوم بالتعمية على التفاصيل؟
أليس من الواجب تحديد من القاتل ومن المقتول، وترك البحث في أسباب وقوع الجرائم لعلماء الاجتماع والباحثين النفسيين؟!
ينطبق ما سبق على عبارة “إنها الحرب”، والتي استخدمها بعض مثقفي النظام، بعد انفضاح جريمة واحدة من مئات وآلاف الجرائم التي ارتكبها جنوده وعناصره الأمنيين، بحق السوريين!
العبارة هذه، تشبه كيساً مطاطياً، يريد هؤلاء “الجهابذة” منا أن نقر بها، لتكون مبرراً لجرائم هائلة، إذ يمكن من خلالها تبرير التهجير، والتدمير، ودفع المدنيين لتلمس الأمان في أي مكان، بينما كان واجب الدولة حمايتهم، وليس قتلهم بأبشع الطرق، بحجة كونهم بيئة حاضنة، أو يعيشون في منطقة تحت حكم المسلحين أو الإرهابيين! ومن خلالها أيضاً يكون من المطلوب التسامح مع أفعال الإبادة التي جرت في سجون النظام، وعلى حواجز عناصره في الطرقات، وغير ذلك!
يقول هؤلاء بعبارة شبه صريحة: لا يجب أن يعترض أحدٌ على ما حدث، لأنها الحرب!
لا، إنها ليست الحرب، بل إنها الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وفق نمطية محددة، يظهر فيها دائماً جنود أو رجال أمن أو أشخاص مؤيدون للأسد، يقتلون مدنيين، أو عسكريين، لا يهددونهم في لحظة وقوع الجريمة، بل كانوا موقوفين! أي أن الضحايا، قتلوا دون وجود أي مبرر!
لن نتحدث هنا عن طقوس القتل، فهذا بحث آخر، لكن وجود نمط عام من الأداء الذي يتكرر في مثل اللحظات، لا يمكن تفسيره من زاوية تقول بفردية هذه الأفعال، إنها أفعال مبرمجة، ومقررة، ومتفق عليها، وتحدث تحت عيون القادة، الذين يشاركون أحياناً في ارتكابها!
كل الجرائم التي وقعت في سوريا، وبما فيها قتل الأسرى من جنود النظام، وكذلك اختطاف وقتل المدنيين المؤيدين، أو الذين تم أخذهم على الشبهة في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، أياً كانت، يجب أن تتم قراءتها من زاوية الإدانة، والبحث فيها، ومتابعة مرتكبيها، وتوقيفهم ومحاسبتهم، وأي تبرير “متفذلك” في هذا السياق، لا يستحق فقط الإدانة، بل التجريم أيضاً، لأن هذا يدخل في باب التحريض على معاودة الفعل وتكراره.
عادة ما يُسجل المثقفون في زمن الحروب والويلات شهادات موجعة عما جرى ويجري، يدينون من خلالها بشكل صريح، أو بشكل غير مباشر، الجرائم المرتكبة فيها، ويؤشرون لمن فعلها، إلا في سوريا، فهنا في هذا الفضاء الدموي، تم توليد كينونة المثقف الحربي الإجرامية، الذي لا يكتف بتبرير جرائم القتلة، بل لديه اندفاع كبير لأن يحمل سلاحاً ويشارك في الإبادة!
تلفزيون سوريا
—————————-
في الهولوكوست السوري.. المجرم شاهد على نفسه/ وفاء العلوش
لا يمكن للمرء أن يخلق دليلاً لنفسه، قاعدة قانونية متعارف عليها في القوانين والتشريعات، لكن ذلك لا يمنع أن يخطئ المجرم ويتورط في الاحتفاظ بأدلة تدينه، وقد يستمر بالعودة إلى مسرح جريمته مراراً وتكراراً.
المجرم في القضية السورية لم يحتفظ بالأدلة عن طريق الخطأ وإنما من باب المفاخرة بهزيمة الطرف الآخر، إنه لم يغادر مسرح جريمته ولم تزعزعه المحاولات المختلفة لإزاحته، منذ اندلاع الثورة السورية مروراً بالمآسي المختلفة التي عانيناها كسوريين لإثبات أحقيتنا في التمرد ضد طاغية وسفاح لم يشهد العصر مثله.
لم يأخذ القَتَلة في سوريا فترة استراحة كانت الأفرع الأمنية والآلة العسكرية مستمرة بالتنكيل في الناس والجثث من دون كلل، فيما كان البقية يُهجرون ويُعتقلون من دون حساب، فلم يكن منا في مواجهة التخلّي العالمي عن دعم الثائرين، وتحت وابل الصواريخ والبراميل التي تستهدف المدنيين وبعد النزوح من آلة القتل السورية وشركائها، سوى أن نلجأ إلى جمع الأدلة وتوثيقها وتوثيق أسماء المعتقلين والشهداء والمفقودين لغاية تقديمها للمحاكم المختصة لتكون بارقة الأمل الأخيرة في سبيل تحقيق العدالة.
كان ذلك استحقاقاً رئيساً بعد أن جهدت وسائل الإعلام والمنظمات على تشويه صورة الثورة وتحويلها إلى حالة حرب داخلية ونزاع أهلي، وإسقاط صفات الثورة ضد الاستبداد عنها في محاولة لإلباسها ثوب الحرب الأهلية، بحيث يتساوى الأطراف وتنتفي أحقية المطالب السياسية والإنسانية التي خرج السوريون لتحقيقها.
في الوقت الذي جهد الناشطون ومكاتب التوثيق للبحث عن أدلة تدين الأسد والأجهزة الأمنية المتورطة في دم السوريين لجمعها وتقديمها للمحاكم الدولية بهدف الانخراط في مسار قانوني يحقق العدالة ولو بجزء منها، كانت عناصر هذه الأجهزة توثق جرائمها وكأنها في احتفالية نصر ويتناقلونها ويعيدون مشاهدتها بفخر ونشوة من دون أدنى اعتبار لما قد يحصل لو أن تلك الوثائق وصلت إلى يد الطرف الآخر.
قد يبدو سلوك المجرم الذي يوثق جريمته مرَضيّاً وبحاجة إلى تحليل علم نفس المجرم للتأكد من سلامته العقلية والنفسية، لكن الأمر هنا يبدو مختلفاً إذ يبدو وكأن المتورطين في عمليات القتل والتعذيب واثقون من قدرتهم على الإفلات من العقاب، ما يمنحهم الجرأة في أن يرتكبوا مثل تلك الفظائع، فلا يتوانون عن إطلاق خطاب كراهية والدعوة إلى تجريد من يخالفونهم الرأي من جنسيتهم، أو توزيع شهادات وطنية أو سحبها بحسب ما يناسبهم، ولا يوجد رادع يمنعهم من الذهاب إلى الحدود القصوى في تعذيب خصومهم.
الروايات التي يعرفها الباحثون والمهتمون والرأي السوري العام عن ممارسات الجهاز الأمني والتشكيلات التابعة له مع المعتقلين، تشي بكم الوحشية المتعمدة في أقبية الموت، فأولى ممارسات التعذيب وأخفها وطأة أن يجعلوا المعتقلين يستمعون إلى صرخات المعتقلين الذين يعذبون في غرف أخرى، لمحاولة التأثير نفسياً عليهم، ثم تتدرج المراحل حتى الوصول إلى أقصاها.
يبدو استخدام التعذيب أمراً منهجياً في المعتقلات السورية أو خارجها وليس سلوكاً فردياً أو حدثاً قد يحصل مصادفة، كما يبدو انتفاء وصف التعامل الإنساني بداية منذ منح المعتقلين أرقاماً بدلاً من أسمائهم، وقد يتمادى المحققون بحيث يجبرون المعتقل على قتل الآخر وحمل جثته لدفنها أو حرقها في مكان ما.
وإذا أردنا تكثيف الفكرة فالنظام السوري لا يهتم بأنه من باب الحكمة بألا يحتفظ الجاني بدليل على هذه الجريمة التي اقترفها، بل قد يتعدى الأمر ذلك بحيث يفاخر القتلة بكم الجرائم التي اقترفوها وقد يعتبرونها معيار بطولة، حتى أنهم مرتاحون بفعل القتل والتعذيب وكأن العالم قد منحهم رخصة لاقترافها وحصانة ضد العقاب بسببها.
لم تغير كل الوثائق والمستندات المرئية والمسموعة التي جمعتها مكاتب التوثيق من سلوك العالم تجاه القضية السورية كما لم تجعل المجتمع الدولي يتخذ قرارات حاسمة تجاه سفاحي وقتلة الشعب السوري، وهذا بدوره أثّر على تكرار السلوك من دون أدنى خوف لظهور مثل هذه الأدلة للعالم أو تقديمها للقضاء الدولي، لأنهم يعرفون أن لعبة توازنات السياسة قد تجعلهم في موقع المنتصر حتى وإن كان على حساب الضحايا.
وإلا فلماذا لم تؤثر شهادات الناجين والناجيات في الملف السوري وهم الأكثر دراية بالممارسات الوحشية وقد عايشوها؟ أو لماذا لم تسهم الصور والمشاهد الموغلة في العنف والدموية بتغيير فكرة الرأي العام العالمي عن الثورة السورية والاعتراف بها على أنها حق للسوريين في مواجهة الموت اليومي المتكرر، لماذا لم يسحب المجتمع الدولي الشرعية من نظام الأسد أو عمل على ردعه عن وحشيته على أقل تقدير؟؟
لم يعد السوري منا ينتظر إجابة لهذه الأسئلة فهو يعرف علم اليقين أن في جعبة المجتمع الدولي بمنظماته المدنية وتشكيلاته القضائية ما يمكن أن يدين النظام بالدليل القاطع ويجعله معزولاً دولياً ويعرضه لأقصى العقوبات، لكن وبما أن التجاذبات السياسية في المنطقة لم تحقق التوازن المرجو منها بعد، فإن الورقة السورية ما تزال قابلة للاستخدام ما يعني أن المحاسبة لا يمكن انتظارها على المدى القريب وقد تأخذ وقتاً أطول مما اعتقدناه أو حلمنا به.
لقد كانت صور قيصر فضيحة عالمية ثم مجزرة التضامن، استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة والحولة، مآسي مهجري الخيام، واكتشاف مقابر جماعية تدل على الهولوكوست السوري، لكنها لم تغير في مسار الملف السوري وأخذت حصتها من الإعلام ثم تلاشى أثرها مع الوقت، فهي لم تؤثر في الضمير العالمي شيئاً ولم تحدث انعطافة تاريخية في الملف السوري، ولم تنصف الثورة السورية في الوصف.
لقد كانت المجاهرة بالعنف هي الجريمة الأكثر وضوحاً لدى النظام السوري المستبد، ففي حين يحاول كل مجرم إخفاء أي أثر يدل عليه ويجعله عرضة للعقاب والحساب، كان النظام في دمشق لا يخشى في العنف لومة لائم ولا يهمه أن يُساق به إلى أروقة المحاكم الدولية أو إدانته بالإبادة الجماعية.
تلفزيون سوريا
—————————–
فوق “جسر التنهدات” تحت جسر الرئيس/ مالك داغستاني
بعد أن اعتقد السوريون، لعقدٍ كامل، أن لسجون حافظ الأسد (صمّام عدم رجوع). أصدر حافظ الأسد عفواً (عاماً) نهاية عام 1991. شمل العفو قرابة 2800 سجين قضوا في سجونه ما بين ثمانٍ وعشر سنوات، معظمهم من الإسلاميين ممن حكمتهم المحكمة الميدانية بالبراءة، وجُلّهم كانوا من الأحداث لحظة اعتقالهم. كان من نصيب سجن صيدنايا، حيث كنتُ، عدة مئات غادروا السجن على دفعات يومية. دخلوا السجن مطلع الثمانينيات يافعين وأطفالاً وغادروه شباباً ورجالاً.
كان في جناحٍ فوقنا، سبعة معتقلين من الحي الصغير ذاته الذي تربيت فيه، “مساكن المعلمين” في مدينة حمص. سبعةٌ ممن نجوا من مجزرة تدمر والإعدامات هناك. نعم، كانوا أحداثاً حين اعتقالهم ولذلك حكمتهم المحكمة الميدانية “براءة”، ومع ذلك قضوا في السجن تسع سنوات، بينما كان اثنان آخران من جيران الحي قد فقدا حياتهما. أحدهما في مجزرة سجن تدمر الشهيرة، والآخر إعداماً. سيتصادف أن تتلى أسماء خمسة منهم في الدفعة ذاتها فيخرجون إلى الحياة معاً، في حين سبقهما الآخران قبل يوم واحد. بين تلاوة أسمائهم وخروجهم، كتبوا لي رسالة شكر، فقد كنت صلة الوصل بينهم وبين أهاليهم في الفترة الماضية. كانت تلك الرسالة من بين أجمل الرسائل التي تلقيتها في حياتي.
في الحافلة من دمشق إلى حمص، عرف السائق أن معه معتقلين من حي واحد. في المدينة، لم يدخل الرجل إلى الكراج، بل أنزل الركاب على بوابته، ومضى بالخمسة المتبقين، إلى حيّهم. في ساحة “المساكن”، أطلق الرجل، على مدى دقائق دون توقف، أبواق الباص العالية. يومئذ اندلعت الزغاريد من الشرفات. ونزل الناس إلى الساحة، دون أن يلتفتوا لما عليهم من ثياب. نعم نزلت الأمهات والآباء والإخوة وكل الجيران، ليستقبلوا العائدين من الموت.
حوَّل سائق الباص الخروج الاعتباطي إلى حالة من الاحتفال، في حيّ جريح، بمدينة ككل المدن السورية جريحة، في بلد يعيش أهله على حوافّ الموت منذ عقود. يوم العفو ذاك، فرحت مئات العائلات السورية، في حين بقيت آلاف الأسر تنتظر لسنوات أخرى، من تلك الأسر ما زالت تنتظر حتى اليوم أبناءها الذين اختفوا قبل عقود. ما أردت الحديث عنه هنا هو هذا السائق. بدا لي وكأنه يمثل جمال الناس بمواجهة بشاعة السلطة، فكل بشاعةٍ وقبحٍ وسوءٍ في سوريا، كان خلفه نظام الأسد، حتى لو بدا ظاهر الأمر غير ذلك. فبينما يقوم نظام الخراب بسحق كل ما هو جميل، يحاول سوريون طبيعيون وبسطاء أن يزينوا الحياة ببعض اللطائف كلما استطاعوا.
إذاً حدث ما يشبه الذي يجري اليوم قبل نحو 30 عاماً. يومئذ أيضاً خرج السوريون هائمين على وجوههم، إلى مداخل المدن ومواقف الحافلات، حيث يتوقعون وصول الأبناء الغائبين منذ سنوات طويلة، دون أية معلومة عنهم. كان الناس كالسكارى وما هم سكارى، يفتشون في حالة من الهيستيريا، كل حافلة تمر. ويومئذ كنت، وآلافاً آخرين، ممن لم تشملهم قوائم العفو. فقط نسمع عما يجري في المدن السورية، عبر ما يرويه لنا الأهل في زيارات السجن.
نحن لا نختار الحقبة التي نولد ونعيش فيها. أقصى ما نستطيعه هو التكيف مع معطياتها ومجرياتها وأحداثها. هذا التكيف لم يكن سهلاً على البشرية في كثير من الحقب. فالتاريخ البشري مملوء بالمآسي، أوبئة وحروب وكوارث طبيعية ومجازر. إذاً لنعترف بدايةً، أن عيش السوريين في حقبة الأسد ليست استثناء في التاريخ الإنساني. ومع ذلك فإن شعورنا المرير بغضبة الحياة علينا، هو أيضاً شعور طبيعي، فكل المجموعات البشرية التي عاشت الكوارث قبلنا أصابها هذا الإحساس. ومن نجا حاول التحايل على الحياة بدل التكيف الطبيعي معها.
يتابع السوريون مشاهد خروج بعض المعتقلين من سجون الأسد الابن. صور كثيرة ووقائع قليلة، وأقل منها الأسماء. صور نادرة لناجين يحضنون أهاليهم. كل هذا يجعل الحالة أكثر غموضاً، والغموض فن خاص كان الأسد الأب أكثر من أتقنه. بينما يبدو مشهد المتجمعين تحت الجسر في وسط العاصمة دمشق، يشبه الحكاية السورية منذ أكثر من نصف قرن. كل ما جرى ويجري من خراب سوري، على كل الأصعدة خلال تلك العقود، كان يجري تحت نظر وأوامر وتوجيهات و(جسر) الرئيس. حتى ليمكننا تكثيف الحكاية السورية بكاملها منذ نصف قرن، من خلال حكاية سجون الأسد.
على هامش المشهد، تحت الجسر وفي مداخل المدن السورية، حيث ينتظر السوريون، آملين أن يكونوا من بين المحظوظين الذين نجا أحبتهم من مجزرة السجن السوري المستدام. على هامش استهتار الأسد بأرواح السجناء المفرج عنهم، تتسرب حكايات صغيرة تشبه حكاية السائق عام 1991. عائلة احتضنت سجيناً ريثما يجد أهله، مساعدة مالية قدمها أحدهم لسجين كي يستطيع الوصول إلى مدينته، وغيرها من تلك الحكايات التي تؤكد مسألة أساسية، كيف أن نظام الأسد يخالف كل سلوك بشري طبيعي، وكيف أن الناس البسطاء والعاديين يصححون ويخففون عن الضحايا نتائج جلافته. لن يخوننا التعبير لو قلنا، إنهم يرممون قبحه ببعض جماليات سلوك البشر العاديين.
فوق نهر “ريو دي بلازو” في مدينة فينيسيا الإيطالية، يمتد “جسر التنهدات”. ليصل بين قصر “دوج” الذي احتوى خلال تاريخه الطويل مقراً لمحاكم التفتيش، وبين السجن في الجهة المقابلة. بُني الجسر الشهير في مطلع القرن السابع عشر، وسمي باسمه الحالي في القرن التاسع عشر، بفضل قصيدة للشاعر الإنكليزي “بايرون”. عليه كان يمر السجناء المحكومون بالإعدام، لينتقلوا من المحكمة إلى السجن. هناك كانوا يطلقون آهاتهم وتنهداتهم الأخيرة قبل موتهم.
على العكس من جسر البندقية، المعروف بجماله الذي ألهم معماريين آخرين لتقليده في عدة أماكن من العالم. يقع وسط دمشق “جسر الرئيس” وهو (صرحٌ إسمنتي)، بُني زمن الأسد الأب، وكمعظم ما خلفه المِعمارُ الأسدي والبعثي عموماً، على قلّته، فإن الجسر يتسم بالقباحة. ولأن للبعثيين والأسديين ذوقهم الخاص، فقد سمّوه لشدة فخرهم به، باسم الرئيس. ليشتهر فجأة خلال الأسبوع الماضي، ويطلق عليه السوريون أسماء جديدة، “جسر الانتظار” أو “جسر المجزرة”.
تحت الجسر، رأينا وسمعنا جزءاً بسيطاً، لكن ليس دون دلالةٍ، من مآسي السوريين الذين ناموا هناك، وفي أمكنة أخرى على أمل عودة المختفين. امرأة شابة من بين المنتظرين، ستقول في مقطع مصور: “بس يخبرونا إذا موجودين أو لاء. إذا عايشين أو ميتين. أبي وأخي صارلهم تسع سنين. لليوم ما منعرف عنهم شي”. هل يبدو طلبها بسيطاً؟ إنسانياً طبعاً، هو من أبسط حقوقها، أما سورياً في زمن الأسد فلا، ليس بسيطاً على الإطلاق. معرفة مصير عشرات وربما مئات الآلاف من المختفين سيكون كارثة لنظام الأسد، رغم قدرته على احتمال أن يكون نظاماً أكثر من كارثيّ. فالغموض هو ما يجب أن يستمر مكتنفاً هذا الملف منذ ثمانينييات القرن الماضي وحتى اليوم. ملف المعتقلين والمختفين يجب أن يبقى على هذا النحو، كي لا يظهر حجم الجريمة. هذا ما فعله حافظ الأسد، وهو ما يتابعه وريثه اليوم.
يتحدث أحدهم عن امرأة رأت صورة ابنها بين صور قيصر للقتلى تحت التعذيب، ومع ذلك تخرج كل يوم لتنتظر مع آخرين ابنها الذي لن يعود. قوة الأمل تصنع المعجزات، لكن لم يحدث يوماً أنها أعادت القتلى من موتهم. عام 1991 كان أبي ينتظرني، حالُهُ حال عشرات الآلاف، ممن خاب أملهم بعد أيام قليلة من العفو. كان يومياً يخرج للطريق صباحاً ولا يعود إلا بعد أن يهدّه التعب، ليجلس أمام الشباك ويتابع الانتظار. كان على أبي أن ينتظر بعدها خمس سنوات أخرى ليراني عائداً، وأراه أنا بعد تسع سنوات من الغياب، كانت كافية لتقوم بتهديمه النهائي.
قد يلخص القول المخزي للرئيس الفرنسي ماكرون، الذي أطلقه عام 2017، حالَ السوريين مع الأسد: “الأسد ليس عدواً لفرنسا، إنه عدو السوريين”. إشهار السوريين اليوم لصور المختفين أمام العائدين علَّهم يتعرفون عليهم، وانتشار مئات الصور وآلاف الأسماء للمفقودين على مواقع التواصل بشكل غير مسبوق، يدلل بصورة لا تقبل أية مراوغة، أن السوريين لا يعيشون في دولةٍ، كان من واجبها أقلّهُ، أن تخبرهم بالمعلومات عن أبنائهم، وإنما تحت حكم مافيات ترتكب الجريمة وتحاول إخفاء آثارها. دولة يحكمها “عدو السوريين” بحسب ماكرون.
في بلاد الألم والقهر والجوع والإخفاء والموت والمجازر الجماعية. سوريا التي ما زالت منذ نصف قرن تسير فوق نهرها على “جسر التنهدات”، فإن معظم السوريين اليوم، بمن فيهم الموالون، إما يسيرون على جسر تنهداتٍ ما، ويطلقون آهاتهم من الجوع والحرمان وانعدام أسباب الحياة، أو أنهم يقبعون تحت جسر الرئيس، وهم يذرفون الدموع. فبينما كان المحكومون بالموت فقط هم من يطلقون آهاتهم فوق جسر البندقية، فإن ملايين السوريين، فعلاً أو مجازاً، ينتحبون اليوم تحت جسر الرئيس. يا لقسوة الحقبة التي عشناها! أكان على السوريين احتمال كل تلك التراجيديا لأكثر من نصف قرن؟
تلفزيون سوريا
———————–
في عالم ما بعد المجزرة/ رائد وحش
عالم ما بعد المجزرة أقسى ممّا قبلها. فحيث إنه عالم انكشاف الحقيقة بالأدلة والبراهين التي لا يُداخلها شكٌّ، إلا أنه أيضًا عالم مواجهة الناجين والباقين لعجزهم.
كلُّ ما جرى واضحٌ أمامهم. ما من حاجة إلى شروحات. مع أن الشرح موجود من قبل والآن حصلوا على ما يثبّته.
يعرفون الجريمة مثلما يعرفون سواها. يعرفون مرتكبيها. لكنهم عاجزون عن الإتيان بفعلٍ، فلا يزال المجرمون يتمتعون بحصانة وحماية تجعلهم لا يُفلتون من العقاب وحسب، بل يقفون في وضعية التأهب الكاملة لارتكاب المزيد من المذابح. ولهذا يسامون سوء العذاب وهم يرون كيف يخفّ اهتمام الناس يومًا تلوَ يوم، وكيف يتضاءل تركيز الإعلام رويدًا رويدًا، مُفسحًا المجال بخبثٍ مدروس للنسيان حتى يحتل المشهد. لكنّ الذي يكسف شموس أيامهم في تلك اللحظة أنهم يدركون أن كل هذا الموت لن يغيّر شيئًا في الواقع.
من أجل ذلك يشعر الذين جرحتهم الأخبار والصور والفيديوهات والرسائل المنشورة واعترافات القتلة، في عالم ما بعد المجزرة، أنهم يتعرضون لمزيد من التنكيل، ويتجرعون كميات من الإهانة أكبر من طاقة الذلّ العاديّ على الاحتمال.
حتى لا يبقى ضحايا المجازر مادةً لمشاعر التضامن العابرة، وموضوعًا للاستهلاك الإعلاميّ، ليس أمامهم سوى خيار واحد: أن يتمسكوا بروايتهم ولا يصمتوا عنها. أن يستمروا في الحديث عن المجزرة حتى يبنوا وجودهم ومعناهم حولها وعليها. حتى تصبح العظام المفتّتة واللحم المحروق هو ما يجمعهم. فيكون أولئك الذين ألقوا إلى حفرة الجريمة سببًا لصناعة هوية جديدة ترفض كلَّ ما يمت للقتلة بصلة، وتنادي بالإنصاف والحقيقة، فيصبح للعدالة جماعتُها الموحدة. وإلّا ما الذي يجعل النظام السادي يخشى تشكّل هذه الجماعة إلى هذا الحد، فيحاول تمزيقها قبل التئام أجزائها بإفراج محدود عن معتقلين من منطلق “العفو عند المقدرة”، مع أنَّ سجن هؤلاء الناس بلا سندٍ أو دليلٍ جريمةٌ أخرى. ولأنه يعرف ذلك يخيف الناس بالإيحاء الضمنيّ أنّ كلامهم حول الجريمة يمنع الإفراج عن ابنتهم أو ابنهم. بالخوف، سلاحه الأمضى، يُوحي للبسطاء أن كلامهم سيؤذي المعتقلين. وكأنّ بالمعتقلين يتكئون على الأرائك في جنات النعيم! وكأن بهم سوف يُنقلون إلى طبقات الجحيم الدُّنيا بسبب كلام ذويهم!
وبذلك يبدع في تفتيت جماعة العدالة.
هذا ما يحدث بعد مجزرة واحدة، فما الذي يقال عمن يولدون في كنف مجزرة، ويكبرون على تخوم أخرى، ثم يتزوجون أو يُنجبون بالتزامن مع مذبحة جديدة، وفي آخر المطاف ينتهون في مقبرة جماعية.. ما الذي يمكن أن تقوله اللغات عن هذه الحياة المسيّجة بالمجازر؟ وكيف لنا أن نحتسب هذا الذي نعيشه حياةً لا مجزرةً بينما تحيط هذه الدماء كلها؟
أما مجزرة التضامن فعلى السوريين أن يجعلوها إطارًا لسردية الظلم السوري، لأن الشكل الذي قُدّمت به هو الشكل الأمثل لكتابة التاريخ، وإذا كانت هذه الكتابة تحتاج في العادة إلى سنوات من الجهد والتنقيب، وتظهر نتائجها بعد عقود طويلة من الجريمة، بحيث يصعب أن يأخذ العدل معناه دون ارتباطه بالحقيقة، فإن مزايا التكنولوجيا الحديثة سهّلت إمكانية الكشف والإثبات السريعين، قبل انتقال سوريا إلى زمن آخر، وفي زمن حياة ذوي الضحايا.
في مجزرة التضامن إثبات لما عاشه السوريون من موت قوبل بالإنكار، وجرى النظر اليه كجزء طبيعي من الحرب الأهلية، وكأن الأمور قبل ذلك كانت في حال من التساوي بين أطراف متصارعة على الأرض، وهو قول يرقى بذاته إلى مستوى الجريمة الأخلاقية، لأن الجرائم الكبرى لا تحدث بالسلاح والقتلة فقط، بل تلحقها، كما سبقتها، عملية تأثيم للضحايا بما يجعل من قتلهم واجبًا، ومن قاتليهم أبطالًا.
ولأن هذا النوع المروّع من الجرائم يُغيّر كل شيء، ولا يُبقي مكانًا للأفكار القديمة أو للمقاربات السابقة، لن تكون أسئلتنا: من الذي يختار ما الجريمة الكبيرة؟ وهل مجزرة التضامن هي الأكبر أو الأهم؟ بل: ما الذي يجعل مجزرة التضامن مهمة؟ والجواب: الوضوح.
لأن كل شيء واضح ها نحن قادرون على تحديد الضحايا والجزّارين. ولأن كل شيء واضح يصبح هذا المشهد اختصارًا لما حدث في سوريا طوال عقد من الدم. التضامن تلخيص. والذي يريد القضاء عليها لا يريد إلا أن يقضي على وضوحها.
في عالم ما بعد المجزرة ثمة سوريون يائسون من وجود الرحمة والتعاطف في هذا العالم، ولهذا يتعاملون مع ما حدث على أنه موت شخصيّ لكلٍّ منهم، وينظرون إلى تلك الحفرة على أنها حاضرهم.
ولكي نتجاوز عالمًا يقيم في فخّ ما بعد المجزرة علينا أن نعيد ترتيب خطابنا على أساسها.
الترا صوت
—————————
“عفو الأسد”… محدود ولا يشمل معتقلين ليسوا سوريين/ أمين العاصي
تعتقد الأمم المتحدة أن إطلاق النظام السوري لمئات المعتقلين في سجونه تطور جديد يمكن البناء عليه من أجل التوصل لحل سياسي للقضية السورية، بينما الوقائع تشير إلى أن هذا النظام لم يطلق إلى الآن سوى مئات المعتقلين من بين عشرات آلاف من المفترض أن يشملهم قانون “العفو” الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد في 30 إبريل/نيسان الماضي.
بيدرسن يرى “عفو الأسد” تقدماً
وقال المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، في كلمة له أول من أمس الثلاثاء، أمام مؤتمر المانحين في بروكسل، إنه ينوي طرح قضية المعتقلين لدى النظام السوري خلال زيارة مقررة له إلى العاصمة السورية دمشق في وقت لاحق من شهر مايو/أيار الحالي، للتحضير لجولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
وأعرب عن اعتقاده بأن إفراج النظام عن عدد من المعتقلين خلال الأيام القليلة الفائتة “من شأنه أن يرسل إشارة مهمة لجميع السوريين مفادها بأن التقدم ممكن”، مضيفاً: “يرى الكثيرون في هذا تطوراً جديداً مهماً محتملاً نظراً إلى أن عدداً كبيراً من السوريين يمكن أن يستفيدوا منه”.
وبدأ النظام السوري مطلع الشهر الحالي الإفراج عن معتقلين على دفعات بعد صدور “عفو” من بشار الأسد في 30 إبريل الفائت، عما أسماها بـ”الجرائم الإرهابية”، في محاولة لوسم المعتقلين بصفة الإرهاب.
ويبدو أن المبعوث الأممي يرى أن إطلاق عدد محدود من المعتقلين يتناغم إلى حد ما مع سياسة “خطوة بخطوة” التي أعلنها بيدرسن العام الفائت، في محاولة لدفع النظام لتسهيل مهمة الأمم المتحدة في تنفيذ القرار الدولي 2254 (الصادر عام 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية) الذي لا يعترف به النظام.
إفراج عن مئات المعتقلين السوريين من بين عشرات آلاف
وكان من المتوقع أن يخرج عدد كبير من بين نحو 130 ألف معتقل موثقة أسماؤهم لدى منظمات حقوقية، إلا أن النظام لم يفرج حتى أمس الأربعاء سوى عن مئات الأشخاص، وهو ما يعزز الاعتقاد بأنه قتل منذ عام 2011 الكثير من هؤلاء المعتقلين.
ووثقت “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا” الإفراج عن 136 معتقلاً من سجن صيدنايا سيئ السمعة، منذ صدور مرسوم “العفو”، مشيرةً إلى أن “القائمة غير نهائية والعدد قابل للزيادة في الأيام المقبلة”.
وأوضحت أن “سبعة أشخاص من المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم إلى العام 2011، وثمانية أشخاص يعود تاريخ اعتقالهم للعام 2012”. وأضافت أن “51 شخصاً من المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم للعام 2018، في حين لم نستطع تحديد تاريخ دقيق لاعتقال 31 شخصاً”.
سجون النظام/ سورية/ سياسة/ 08 – 2016
وبيّنت الرابطة أن “103 أشخاص من المفرج عنهم من سجن صيدنايا، نظرت محكمة الميدان العسكري في قضاياهم، بينما نظرت محكمة الإرهاب في قضايا 14 شخصاً”. وأشارت إلى أن “19 شخصاً من المفرج عنهم لم تنظر أي محكمة في قضاياهم خلال فترة احتجازهم، أو لم نستطيع تحديد المحكمة التي نظرت في ذلك إلى الآن”.
ولفتت الرابطة إلى أن “محافظة ريف دمشق تأتي في المركز الأول من حيث عدد الأشخاص المفرج عنهم منها، تليها محافظة درعا في المركز الثاني، ومحافظة حمص (مدن وبلدات ريف حمص الشمالي) في المركز الثالث”، بينما “لم يسجل الكثير من الأشخاص المفرج عنهم من محافظات اللاذقية، ودمشق، ودير الزور، وحلب”.
ويعد معتقل صيدنايا شمال شرقي العاصمة دمشق، بمثابة “مسلخ بشري” وفق توصيف منظمة “العفو الدولية”، التي وثقت في منتصف عام 2016، مقتل 17723 معتقلاً أثناء احتجازهم في سجون النظام السوري، ما بين مارس/آذار 2011 وديسمبر/كانون الأول 2015، أي بمعدل 300 معتقل كل شهر.
في السياق، أوضح مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الشبكة “وثقت ما لا يقل عن 429 شخصاً تم الإفراج عنهم من قبل قوات النظام من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية في الفترة الممتدة من بداية الشهر الحالي وحتى صباح (أمس) الأربعاء”.
ووفق عبد الغني، فإن “من بين المفرج عنهم 48 امرأة، و8 أشخاص كانوا أطفالاً حين اعتقلوا”، مشيراً إلى أن “من بين حصيلة المفرج عنهم 6 حالات لمختفين قسرياً، لم تكن عائلاتهم تحصل على أي معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، ولم تتمكن من زيارتهم حتى ولو لمرة واحدة”.
ولفت إلى أن القوائم التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن المفرج عنهم “مليئة بالأخطاء”، مضيفاً أن “بعض المنظمات تنشر معلومات بناء على هذه القوائم، وليس استناداً على توثيق الحالات”.
وقال عبد الغني إن “هناك حالات إفراج عن معتقلين بشكل يومي”، مشيراً إلى أن “عمليات التوثيق الصحيحة لعدد المفرج عنهم هي من صلب عمل الشبكة، وهناك أكثر من 13 شخصاً يقومون بهذه المهمة”.
إلى ذلك، أوضح المحامي عبد الناصر حوشان (وهو عضو مجلس فرع حماة للمحامين الأحرار) لـ”العربي الجديد”، أن القانون رقم 7 (العفو) الذي أصدره بشار الأسد “جاء محصوراً بقانون واحد، وهو قانون الإرهاب 19 فقط، وبنصوص محددة فيه”. ولفت إلى أنه “خرج عن مفهوم العفو العام الذي يفترض أن يشمل الجرائم السياسية، وجرائم أمن الدولة والجرائم العادية التي تمت ملاحقة كثير من الأحرار بموجبها واعتقال الكثير ومحاكمتهم بها”.
وأشار حوشان إلى أن “عدد المختفين قسرياً ومجهولي المصير هو 84371، لم يخضعوا لمحاكم الإرهاب أو غيرها من المحاكم، في حين أن عدد المعتقلين تعسفياً، الذين لم يحالوا إلى القضاء حتى اليوم ومصيرهم معلوم هو 27593”.
ولفت إلى أن “عدد المعتقلين من غير السوريين يقدّر بـ500 معتقل، وهؤلاء لم يشملهم قانون العفو لأنه خص السوريين فقط”. وبيّن حوشان أنه “من المفترض أن يشمل القانون رقم 7 آلاف المعتقلين في السجون، بحيث يُطلق سراحهم من دون قيد أو شرط”، مشيراً إلى أنه “حتى أمس الأربعاء، بلغ عدد المفرج عنهم 317 معتقلاً”.
وأوضح أن “أغلب المفرج عنهم من مختلف المحافظات، هم مجندون في قوات النظام اعتقلوا بعد بدء التسويات مع الأخير في عام 2018”.
———————————-
======================
تحديث 13 أيار 2022
——————————–
قرابين التضامن: نقاش مع فريق التحقيق
لا تزال المذبحة المروعة التي ارتكبها عناصر تابعون للنظام السوري في حي التضامن عام 2013، والتي كشف تحقيقٌ بعنوان قرابين التضامن عن أبرز تفاصيلها وهوية مرتكبيها، تثير كثيراً من النقاشات والتساؤلات ومشاعر الغضب والحزن في أوساط السوريين وأوساط المهتمين بالقضية السورية. وقد استضافت الجمهورية مساء أمس الأربعاء 11 أيار (مايو) 2022، الباحثَين أنصار شحود وأور أونغر اللذين أنجزا التحقيق، والباحث مهند أبو الحسن أحد مترجمَي النسخة العربية التي نشرتها الجمهورية.نت، للحديث عن جوانب أساسية من هذه النقاشات.
حوار مجموعة الجمهورية مع معدّي مجزرة التضامن أنصار شحّود وأور أونغر ومهنّد أبو الحسن
أدار الزميل عروة خليفة النقاشات، التي بدأت بتقديم الباحث أور أونغر عرضاً مختصراً للعمل على إنجاز التحقيق، شرح فيه أنهم اختاروا منذ البداية التركيز في تحقيقهم على كشف هوية مرتكبي المذبحة كي لا تبقى هذه الجرائم منسوبةً إلى مجهولين، بحيث يمكن للمسؤولين التنصّل من مسؤوليتهم عنها. ويقول أور خلال النقاش إنهم اختاروا طريقة «البحث الاستقصائي المتخفّي»، للتمكن من التواصل مع الجناة عبر خداعهم، لأن هذه الطريقة، التي قد يعتبرها البعض غير أخلاقية، هي الطريقة الوحيدة الممكنة للكشف عن مرتكبي مذابح تنفّذها أنظمة إجرامية مثل النظام السوري.
في جوابها على سؤالٍ حول مراحل العمل على كشف الجناة، تقول أنصار شحود إن العملية بدأت من خلال ملاحظة الفوارق في اللباس العسكري بين مرتكبَي الجريمة الظاهرَين في الفيديو، ما يعني احتمال تبعيتهما لجهتين مختلفتين. جرى التركيز بصورةٍ أساسية على فرع فلسطين وفرع الدوريات، ولكن بعد بحثٍ طويل، تبيّنَ أن الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية هو المسيطر على المنطقة، وبالصدفة تم الوصول إلى أمجد يوسف عبر حسابه على فيسبوك. تضيف أنصار: «في ذاك الوقت، كانت شخصية آنّا الوهمية قد بدأت منذ عامين بالتعرف على مجموعة من المجرمين وإجراء مقابلاتٍ معهم، ثم تم استخدامها للتواصل مع أمجد».
ولكن هل كان لدى آنا شخصية واحدة؟ أجابت أنصار شحود أن «شخصية آنا كانت تتغير بحسب الحاجة وبحسب إطار العمل وطبيعة المجموعات التي نقابلها، وعلى هذا الأساس، وبشكل نسبي، كنا نرسم شخصيتها. هي شخصية تحمل اسماً واحداً، ولكن مواصفاتها تتغير بحسب الشخص الذي تلتقيه، وذلك بعد دراستنا لحسابه على فيسبوك والمجموعة التي ينتمي لها».
وعن المخاطر النفسية والأمنية لهذا العمل تجيب شحود: «كنا قد عملنا سابقاً على إجراء مقابلات مع عناصر مخابرات، ولكنها مقابلات معدودة على الأصابع. نحن هنا إزاء جهاز سرّي قادر على الوصول إلى معلومات عن أي أحد إذا قرَّرَ ذلك، وكان أحد مخاوفنا الكبيرة أن يفكر أمجد بالبحث عن آنّا». تشرح شحوّد كيف أنهم قرروا الحديث معه رغم ذلك، وكيف أنه كان عليها «الحرص في كل تفصيلٍ تناقشه معه». أما عن الصعيد النفسي، فتقول أنصار: «كنا نشاهد إنساناً سبق لنا رؤيته يقتل، وتمكنّا من الوصول إليه وإقناعه بالكلام بعد صبر. كان الفارق الزمني بين أول حديث مع أمجد والثاني عدداً من الأشهر، وذلك حتى كسبنا ثقته وتمكنا الحديث معه دون حواجز وهو مرتاح. تطلَّبَ هذا منا مرونةً مضاعفةً، كأن نتحدث إليه في الساعة الثانية ليلاً. هذا النوع من البحث تطلَّبَ مني العيش مع شخصية مختلفة، والتقلب بين شخصيتي الحقيقية وشخصية آنا المختلفة تماماً، ولهذا بالطبع انعكاسات نفسية كبيرة».
أيضاً، أجاب مهند أبو الحسن عن أسئلة متعلقة بمعايير ومتطلبات، عملية وأخلاقية، لهذا النوع من العمل الاستقصائي. يقول أبو الحسن إن «سلامة الباحث وسلامة المتعاونين معه شرطٌ أساسي، إذ ينبغي أن نكون شديدي الحرص من خلال استخدام وسائل تواصل آمنة وغير قابلة للاختراق». يحتاج هذا العمل أيضاً بحسب أبو الحسن إلى فهم النظام الحيوي أو البيئة التي يتم البحث في نطاقها: «كان من الصعب الوصول إلى أمجد يوسف ونجيب الحلبي دون فهم طبيعة العلاقات بين هؤلاء الناس واللغة المستخدمة بينهم ودلالات اللغة التي يتخاطبون بها. إن فهمَ النظام الحيوي للأفراد والمؤسسات هو شيءٌ أساسيٌ يُجنّبنا الوقوع في معلومات مضللة، لأن الشخص المُقابل، عن قصد أو دون قصد، قد يعطي فهمَه أو استنتاجاته لما نحن بصدد السؤال عنه وليس المعلومة الحقيقية».
يقول مهند إن الأسئلة الأخلاقية الصعبة تحضر دائماً: «رغم أن أمجد شخصٌ قاتل، فإننا قررنا الكشف عن اسمه قبل النشر ببضعة أيام فقط، لأننا سألنا أنفسنا: هل من حقنا تعريض أمجد للقتل؟ فالنظام قد يقتله مباشرةً. هذا مثالٌ عن جدالاتٍ كثيرة حدثت قبل النشر». يضيف أيضاً: «إن قواعد هذا النوع من العمل الصحفي لم يتم الاتفاق عليها بعد، وهناك محاولات جادة لوضع قواعد أخلاقية بشأن ما يمكن استخدامه من أدوات، وإلى أي حد يحق للصحفي التعدي على خصوصية الآخرين. لكن يمكنني الإشارة إلى ثلاثة معايير أساسية الآن: الأمان وفهم البيئة والالتزام بالمعايير الأخلاقية».
أثار التحقيق بعد نشره نقاشاتٍ حول المسألة الطائفية ومدى حضورها في التحقيق وفي تفسير دوافع القتلة، وعن هذا تقول أنصار شحود إن الطائفية كانت أحد الأسباب الدافعة لارتكاب الجرائم في حي التضامن، ولكنها ليست السبب الوحيد: «هذه الجريمة أتت نتيجة عدة دوافع، ويمكننا التمييز بين دوافع السلطة السياسية ودوافع الأفراد المُنفذين». ترى شحّود أن الأفراد لديهم مزيجٌ من الدوافع السياسية والطائفية، بالإضافة إلى الخوف: «وقعت المجزرة في منطقةٍ تحت سيطرة النظام، والضحايا من منطقة تقع بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة فصائل المعارضة. يبدو إذن أن القتلة اعتبروا ضحاياهم أناساً غير أهلٍ للثقة، ومن المحتمل أن يصطفّوا مع الأعداء، وذلك طبعاً نتيجة الخلفية السنيّة لهؤلاء الضحايا. إذن البعد الطائفي أساسي، ولكنه ليس الوحيد». بالنسبة لأمجد مثلاً، تقول شحود إنه لم يُبدِ أيّ دافعٍ طائفي: «بالعكس، هو أصرّ على أن عمله اتّباعٌ لأوامر المؤسسة، ولم يُقدِّم خطاباً طائفياً، كما لم يكن هناك في الفيديوهات نفسها خطابٌ طائفي. ولا نستطيع أن ننسى أن قسماً من مرتكبي المجزرة من السنّة، مثل السعيدي وكثيرين من الشبيحة غيره. وبالعموم، يبدو البُعد الطائفي أكثر وضوحاً لدى الشبيحة من الدفاع الوطني، مثل أبو منتجب». أما النظام نفسه، فلديه أيضاً مزيجٌ من الدوافع الطائفية والسياسية والاقتصادية بحسب أنصار شحود، من بينها «التغيير الديمغرافي للمنطقة»، و«الاستيلاء على الملكيّات فيها».
ثمة سؤالٌ أيضاً عن اختيار فريق البحث للتركيز على التضامن، فيما لدينا منطقة كبيرة هي جنوب دمشق، فيها بالإضافة للتنوع السوري الشديد حضورٌ كبيرٌ للاجئين الفلسطينيين من سكّان مخيم اليرموك ومحيطه، والأرجح أن بين ضحايا المجزرة كثيرين من أبناء مناطق أخرى، بما في ذلك مخيم اليرموك. عن هذا قالت أنصار شحود: «المميز في حي التضامن أنه كان تحت سيطرة النظام السوري، وهذا يُرينا مجازر مستمرة ممنهجة ارتُكبت في مناطق النظام دون وجود نزاع أو عمليات قتال. المجازر تمت بين عامي 2013 و2015، وشهد الموقع ذاته مجازر أخرى في هذه الفترة، فضلاً عن وجود سجون سرية. ولم يكن فقط أهالي المنطقة يُحتجزون في هذه السجون، وإنما جميع الحواجز المحيطة بالمنطقة كانت تعتقل وتسحب المعتقلين إلى داخل حي التضامن، ما جعله البيئة الأساسية لعملية العنف. السجون كانت في التضامن، والتعذيب حصل في التضامن، وعمليات القتل كانت في التضامن. بحسب المقابلات التي أجريناها، فإن المستهدفين بهذه المجازر كانوا في غالبيتهم من هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها، مثل مخيم اليرموك ودفّ الشوك. إذن يتضح أن المستهدفين مدنيون مقيمون في مناطق سيطرة النظام، وهذا يختلف عن تصور سياسي سابق بأنّ من اختاروا البقاء في مناطق سيطرة النظام كانوا في مأمن من المجازر».
أدّت عملية الاستقصاء الطويلة إلى كشف شخصية شريك أمجد في ارتكاب المجزرة، نجيب الحلبي، وكشف مسؤولين آخرين عن المجزرة هم شركاء وقادة أمجد ونجيب. وعن أهمية ذلك قال أور أونغر إن أغلب النقاشات خلال وبعد نشر التحقيق ركزت على بشار الأسد كمسؤولٍ عن المجزرة وعلى أمجد كمنفذٍ لها، ولكن بينهما سلسلة يمكن تسميتها بالإدارة الوسيطة، وهي سلسلة قيادة من جهتين: المخابرات والشبيحة، وكل فرد من هذه السلسلة يعمل مع جهة أخرى أعلى منه، وبشكلٍ متصاعد حتى نصل إلى بشار الأسد. يوضح أونغر: «هذه السلسلة تنفي أي ادعاءاتٍ بأن هؤلاء المجرمين يعملون من تلقاء أنفسهم ولا يأخذون أية توجيهات أو أوامر من النظام، لأن هناك روابط بين مرتكبي الجريمة والقيادة العليا وصولاً إلى أعلى المستويات. وهكذا نرى كيف أن أمجد يوسف ونجيب الحلبي ليسا فردين، ولكنهما يمثلان المخابرات والشبيحة كأجهزة».
وعن سؤالٍ حول الفارق بين مجزرة التضامن ومجازر أخرى موثّقة في أماكن أخرى من العالم، أجاب أونغر أنه «عندما قامت ميليشيا صربية بإعدام بوسنيين، وتم تسريب ذلك وعرضه، كان قائد تلك الميليشيا يصوّر جريمته بمبادرةٍ شخصيةٍ منه. وما يجعل مجزرة التضامن مختلفة هو أنها تشرح كيف أنه لم يسبق لنظام ارتكاب هذا الكم من المجازر، والقيام بأرشفتها بنفسه مع كامل فظاعتها. الاختلاف في سوريا وفي مجزرة التضامن هو أن الكاميرا والكمبيوتر الخاصين بفرع المنطقة قد قاما بأرشفة ذلك بشكلٍ مُنظَّم، وهذا مختلفٌ عن تاريخ مجازر الإبادة التي نعرفها».
تنوعت الأسئلة التي وجهها الحضور للباحثين، وتنوعت النقاشات التي أثيرت على خلفية هذه الأسئلة. وكان من بينها سؤال عن الفترة التي تدرَّبَ فيها أمجد، ومن هم في مثل عمره وموقعه، على القتل، خاصة أنه كان في أواسط عشرينياته مع قيام الثورة، وهو من جيل لم يشهد مذابح النظام السوري الأولى في الثمانينات. عن هذه النقطة قالت أنصار شحوّد إن أمجد عنصرٌ في المخابرات منذ كان في الثامنة عشرة من عمره، وهو مُدرَّبٌ على العنف وممارسة التعذيب منذ ما قبل الثورة بوصفه محققاً في المخابرات، و«التعذيب يحتوي عنصراً قد يكون أصعب من القتل، وهو التماسّ المباشر مع جسد الضحية لفترةٍ أطول»، ثم جاءت مرحلة الثورة وممارسة العنف الواسع ومقتل شقيقه، ما جعله مستعداً للانخراط في أعمال قتل ممنهجة مثل هذه.
أسئلةٌ عديدة أثيرت مراراً حول عائلات الضحايا والمغيبين، وحول ضرورة تقديم العون لهم في محاولاتهم لمعرفة ما إذا كان أبناؤهم من الضحايا الظاهرين في هذه الفيديوهات، وكيفية تقديم هذا العون دون أن يكون الأهالي مضطرين للبحث في فيديوهات بالغة القسوة كهذه بأنفسهم. وعن هذا السؤال قال أور أونغر إن دورهم كباحثين لا يتضمّن التعرّف على الضحايا، لأنهم غير قادرين على القيام بهذه المهمة التي تحتاج إمكانياتٍ لا يمتلكونها، كما أن تصديهم لهذه المهمة بأنفسهم قد يؤدي إلى أخطاء كارثية في تحديد هوية الضحايا، مضيفاً أن الفيديوهات كلها باتت في عهدة الشرطة والمدعين العامين في عدة دول أوروبية، ويتم العمل الآن على إطلاق آلية للتعرّف على الضحايا.
أثير نقاشٌ واسع أيضاً بشأن حديث أنصار شحود عن المجرم أمجد يوسف، عندما قالت إنه بدا من خلال الأحاديث التي أجرتها معه «شخصاً عادياً»، بمعنى أنه لم يُظهِر خللاً نفسياً ولا شخصية «سايكوباثية»، كما قالت إنه كان ينفذ مهمةً موكلةً له بوصفه جزءاً من مؤسسة ترتكب هذه الأعمال بشكل ممنهج. كان هناك وجهات نظر ترى أنه لا يمكن الحديث عن أجهزة النظام السوري بوصفها مؤسسات بيروقراطية لإنتاج العنف، وأن هناك مواصفات ودوافع شخصية ومعها بنى أهلية جعلت أمجد وأمثاله قادرين على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، كما ذهبت بعض المداخلات إلى التأكيد على أن أمجد كان مستمتعاً ومسترخياً أثناء ارتكاب جريمته، بحيث يصبح وصفه بأنه شخص «عادي» أمراً غير صائب. وقالت أنصار شحّود رداً على هذه المداخلات إنها سجّلت هذه الملاحظة بناءً على محادثاتها مع أمجد، وإنها وصلت إلى خلاصات تقول إن أمجد «صُنِعَ ليقتل. خضع لعملية تدريب على كيفية التعذيب والقتل»، مضيفةً إن «العادية» التي كانت تبدو على أمجد أثناء الأحاديث التي أجرتها معه يمكن تفسيرها بالنظرية التي تقول إن هذا النوع من القتلة «لديه حياتان: الحياة العادية والحياة التي ينفّذون فيها أوامر القتل».
لم يكشف تحقيق قرابين التضامن سوى عن مذبحةٍ واحدةٍ راح ضحيتها 41 مدنياً، قتلهم عناصر النظام السوري وأحرقوهم في حفرةٍ جماعية ووثّقوا جريمتهم بالفيديو، وهذا الفيديو واحدٌ فقط من أصل 27 فيديو آخرين، يوثّق فيها المجرمون عمليات قتل 288 ضحية في المنطقة نفسها. يعطينا هذا تصوراً مؤلماً عن حجم الفظاعة المُرتكبة في سوريا على يد النظام الأسدي، وعن أعداد الضحايا الكثيرين الذين لم نصل بعد إلى أي معلوماتٍ حولهم في أنحاء البلد كلّه، كما يظهر جلياً أن المجرمين من أمثال أمجد يوسف ونجيب الحلبي أكثر وأشد إجراماً مما نعتقد بكثير. إن معركة العدالة والحقيقة طويلة جداً، وستتكشّف عن كثيرٍ من المذابح وكثيرٍ من المجرمين، ولا مفرّ من خوضها حتى النهاية.
موقع الجمهورية
—————————–
الجذور الثقافية للتعذيب… أو العنف السوري نقيضاً للمقدس/ محمد سامي الكيال
تثير مشاهد التعذيب والانتهاكات الواردة من سوريا كثيراً من الصدمة والرعب، ويبدو أن هنالك في أهوال ذلك البلد ما هو قادر دوماً على مفاجئة المتابعين، رغم كثرة الشهادات والمرويات المتراكمة عن فظاعة ممارسات النظام السوري منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي، ما يجعل من الممكن الحديث عن خصوصية ما للعنف السوري، ليست نابعة من حجمه أو المدى الذي قد يصل إليه، فقد شهد التاريخ الإنساني، في كل عصوره، ممارسات عنفية أضخم بكثير مما تعرفه سوريا، ومزقت السلطات دوماً أجساد معارضيها وأعدائها بأشنع الطرق، إلا أن خصوصية العنف السوري تأتي من طبيعته الكابوسية، العصية على الفهم والتفسير المباشر، وتحديد الغايات والوظائف والمرجعيات المرتبطة به، وكأن جلادي النظام يكتفون بتحقيق أسوأ ما في لاوعيهم، وأشد ما في كوابيس ضحاياهم رعباً، دون غاية عملية أو عقائدية واضحة.
نحن هنا أمام عنف وظيفي إلى حد ما، بمعنى أنه فعل هادف إلى ضمان بقاء واستمرار نظام سياسي ومؤسساته، ولكن من المتعذر فهم الفائدة الوظيفية المباشرة لكل هذا الاستفزاز العلني، الذي يبدو مجانياً، لمشاعر ذوي الضحايا والمتعاطفين معهم. يمكن أيضاً اعتباره عنفاً طائفياً ومناطقياً، ولكن يصعب تحديد منطقة سورية تعرّضت لعملية تطهير، أو إبادة جماعية منظّمة، كما أن النظام ما يزال مستنداً إلى قاعدة سكانية متنوّعة طائفياً من الموالين. هو عنف بيروقراطي، يوثّق ويؤرشف ضحاياه بأرقام وصور وتسجيلات، ولكنه يترك مجالاً واسعاً لـ»إبداع» جلاديه وخيالهم ومبادراتهم الذاتية، ومن غير المتصوّر أن كل هذه الأهوال المتنوعة، قد مورست تنفيذاً لأوامر محددة مكتوبة، واردة من جهاز ما، ووفقاً لعقلانيته الخاصة، كما حدث في المجازر النازية مثلاً، إضافة لهذا فهو عنف عقائدي، بمعنى أنه يحمل منظوراً ما حول الحياة والبشر والتاريخ، ولكن لا يمكن مطابقته مع أي تصور ديني أو أيديولوجي أو فلسفي معروف.
طبيعة العنف السوري تجعله إذن حالة خاصة، تطرح كثيراً من الأسئلة، الضرورية لفهم التركيبة السورية نفسها، أو البنية العميقة، التي يندرج فيها النظام ومعارضوه، وإذا كان استقصاء الجانب الوظيفي والمؤسساتي في ذلك العنف متعذراً حالياً، وربما على المدى القريب والمتوسط أيضاً، ما دام أرشيف النظام لن يُكشف قريباً أمام هيئات قضائية أو أكاديمية حرة، فمن الممكن تعيين بعض الأسئلة حول الجانب الرمزي والثقافي والأخلاقي للأهوال السورية، ومحاولة الإجابة عليها بالاستعانة ببعض القياس التاريخي والمنظور التأويلي: ما الجذور الثقافية لكل هذا التعذيب والانتهاك؟ وهل يمكن تحديد بنيان رمزي، يعطي لكل هذه الجرائم معنى ما، من منظور مرتكبيها على الأقل؟
العنف الأخلاقي
صيغت نظريات فلسفية شهيرة عما يُعتبر الهول الأكبر في تاريخ البشرية، أي المحارق والمعسكرات النازية، وتشترك معظم هذه النظريات، كما ترد لدى زيغمونت باومان وحنا أرندت وجورجيو أغامبين مثلاً، باعتبار العنف النازي تجسيداً لنمط من العقلنة الحديثة: ماكينة هائلة ذات تنظيم عقلاني- بيروقراطي متين؛ وأيديولوجيا شمولية، تمتلك منظورا تاريخياً خلاصياً، وفهماً معيّناً للقانون، الطبيعي والاجتماعي، أنتجت «حلولاً نهائية»، راح ضحيتها الملايين، في إطار الولاء لدولة شمولية، وجماعتها السياسية المفترضة، قادرة على تحديد معنى جمعي لهندستها الاجتماعية الدموية. بهذا المعنى فإن الجلادين الأفراد، من موظفين ومجندين وفنيين، افتقروا للقدرة على الحكم الأخلاقي، وتكوين تصور كلي عن الأفعال الجزئية، التي كانوا يقومون بها، بل كانوا ينفذون، بنوع من التسليم الأعمى، أوامر ولوائح واردة من جهاز أكثر شمولية وضخامة، يعقلن الأمور بطريقة أوسع من فهمهم المحدود، سالباً إياهم القدرة الفردية على التعاطف مع الآخر، وطرح الأسئلة الأخلاقية التي يثيرها الألم والموت عادةً، ولذلك فالهول النازي لم يكن شخصانياً، بل بارداً ومحايداً وبيروقراطياً. باومان تحدث عن «اللامبالاة الأخلاقية» في الحداثة، بينما اشتهرت أرندت بأطروحتها عن «تفاهة شر» جلادي النازية.
لم يكن الهول النازي ذا فائدة اقتصادية، مثل معسكرات العمل الكولونيالية مثلاً، بل سعياً أكثر شمولية، واتصالاً بعقلنة الطبيعة والتاريخ، لاستئصال مجموعات بأكملها، شُبّهت بأورام سرطانية في جسد الأمة. هذه الإحالة الفيزيولوجية جعلت الجلادين والضحايا في الوقت نفسه مفتقرين إلى الخيار والمسؤولية الشخصية. لا أحد يُعاقِب أو يُعاقَب بناء على خياراته الذاتية، بل تنفيذاً لجراحة تاريخية صعبة تقوم بها السلطة، التي احتكرت العنف والعقل والمسؤولية. بالنسبة لأغامبين فإن رد البشر إلى حالة «الحياة العارية»، أي نزع كل الضمانات القانونية والحقوق الإنسانية عنهم، هو وضع متضمن في قلب الدولة والقانون الحديث نفسيهما، وليس حالة طبيعة على الإطلاق، ويتجسد فيه المعنى الفعلي للسيادة، التي لا تبرز في أوضح صورها إلا في «حالة الاستثناء».
كل هذه الأفكار والتنظيرات قد تتقاطع مع الحالة السورية، ولكنها لا تتمتع بفائدة تفسيرية كبيرة، فالدولة السورية ليست ماكينة عقلانية/بيروقراطية هائلة، وليست معنية كثيراً بعقيدة خلاصية معلمنة. تبقى الرثاثة العامة الطابع الأبرز لـ»المؤسسات» السلطوية السورية، كما أنها ليست كياناً فوق المجتمع أو الأفراد، فحضور الزعامات، العصب، العشائر، إمارات الحرب المناطقية والطائفية (وكل هذا «أهلي» جداً) أساسي فيها وفي آليات اشتغالها، فضلاً عن هذا فهي لا تولي جدلية القانون/الاستثناء أهمية كبيرة، بل كثيراً ما تعمل وفق العرف الشفوي؛ ما تقتضيه تقاليد شبكات المصالح، المرتبطة بعلاقات القرابة والولاء؛ العصبيات الأولية؛ والتأويلات المشخصنة للقانون. من الظلم تشبيه هذه الدولة بدول صناعية حديثة، ذات سمت شمولي أو غير شمولي، دون أن يعني هذا أنها دولة تراثية أو تعيش في عصور سابقة، إنه نمط من «الحداثة» يتطلّب فهمه تجاوز النظريات النقدية المتداولة.
الأهم من هذا أن شخصانية الهول السوري تنفي مفهوم «اللامبالاة الأخلاقية» لدى مرتكبيه. يدرك الجلادون السوريون جيداً ما يفعلون، وليسوا مجرد مسننات مفردة ومحايدة في ماكينة هائلة.. ولديهم تصور أخلاقي ما عن معنى وعدالة ما يقومون به. أنماط التعذيب، التي ظهرت للعلن، تكشف كثيراً من الخيال والاجتهاد الفردي والمنظورات القيمية، ما يجعله عنفاً أخلاقياً، لسنا أمام أشرار «تافهين» بالتأكيد.
التجديف الورع
يمكن اعتبار أن التجديف أسلوب مفضل للجلادين السوريين لإذلال ضحاياهم: يُجبر المعتقلون والمعذّبون على التصريح بأن الرئيس السوري بشار الأسد هو ربهم، في تحريف واعٍ للشهادة الإسلامية. في حالات أخرى يؤكد الجلادون أن الأسد أقوى من الله نفسه، ويسخرون من أمل ضحاياهم بإنقاذ إلهي من جبروته.
ربما كان من الخطأ قراءة هذا التجديف بوصفه مجرد ممارسة طائفية، بل يبدو الأمر أشبه بمحاكاة أرضية لأهوال القيامة والحشر والعذاب الإلهي. يمكن للجلادين السوريين إقامة الجحيم هنا والآن، ما يجعل زعيمهم تجسيداً أرضياً للرب، أكثر قوة بنظرهم، لأن ألمه محسوس وحاضر، وليس أثراً لغوياً من النصوص الدينية. التجديف هنا لا يقوم على إنكار الأخبار الدينية عن الآخرة، بل يمكن اعتباره تأكيداً لها: العدالة الإلهية المطلقة تقضي بألم لا محدود للعصاة. ومبدأ الألم اللامحدود، لأجل تحقيق عدالة ما، قد يشكل أساساً لا واعياً لفعل الجلادين. سبق للباحث العراقي هادي العلوي، في كتابه «من تاريخ التعذيب في الإسلام»، الحديث عن «مقتربات دينية للتعذيب»، مرتبطة أساساً بالمرويات الدينية عن العذاب الآخروي، وقانون العقوبات الديني، بما فيه من بتر وتمزيق للجسد. يمكن لهذا اعتبار تجديف جلادي النظام ورِعاً و»أخلاقياً»: العدالة الإلهية، التي حلّت في شخص زعيمنا، تتطلب هولاً شديداً، له قداسته.
محاكاة الجحيم
المعسكرات النازية بدورها كانت محاكاة للجحيم، ولكن محاكاة معلمنة، تفتقر لإيمان بيوم الدينونة، الذي يحاسب فيه كل إنسان على سعيه الدنيوي، ما يمنحه المسؤولية الأخلاقية الشخصية. الجحيم النازي كان يرفض الخُلَق الفردي، لحساب معادلات تاريخية وطبيعة مجرّدة.
أما الجحيم السوري فربما كان أقرب للحساب الديني، إذ يتم إيلام كل ضحية، بعد وصمها بالمسؤولية الشخصية عن خطيئة انتهاك سلطة الرئيس/الرب. ولكنه نسخة مشوهة عن القيامة الدينية، فهو يجعل العدالة، التي لا معنى لها إلا بالارتباط بقدرة الرب وعلمه، مناطاً بفهم البشر المحدودين. ومن ناحية أخرى لا يقبل بالشريعة الدينية، وأحكامها المعروفة، بل يجعل الدين مخيالاً لا واعياً لتحقيق جبروت السلطة، وزرعه في نفوس المحكومين. بالعودة لهادي العلوي فقد بيّن في كتابه مواقف الفقهاء المسلمين الرافضة للتعذيب غير المرتبط بأحكام شرعية، في مواجهة المخيال الديني الدموي للحكام المسلمين عبر التاريخ.
بناء على هذا يمكن القول إن العنف السوري ليس حداثياً ولا إسلامياً ولا عرفياً. ربما يكون مزيجاً من كل ذلك، وقد يكون هذا سبب طابعه المربك: بنية رمزية مختلطة ومشوشة، قد تشبه البنية الاجتماعية والسياسية السورية نفسها.
كاتب سوري
القدس العربي
———————-
العفو الرئاسي السوري… خارج العلانية الدستورية والقانونية/ وضاح شرارة
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً سابعاً، هذه السنة، في 30 نيسان/ أبريل، قضى بالعفو عن مرتكبي جرائم إرهابية قبل هذا التاريخ، شرط ألّا تكون قد “أفضت إلى موت إنسان”.
والجرائم التي شملها العفو الرئاسي سبق أن عرّف معظمها قانون مكافحة الإرهاب رقم 19/2012، وهذا حل محل قانون الطوارئ الذي بقي سارياً منذ عام 1963، أي طوال 49 سنة كاملة لم تشهد فيها سوريا غير أحكام عرفية استثنائية تساوي بين الحياة العادية وأحكامها وبين حال الحرب وتهديدها وانتهاكاتها، وبعضها عرّفه قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
وحلّ قانون مكافحة الإرهاب المذكور، والصادر في تموز/ يوليو 2012، أي في أعقاب 14 شهراً على الحراك السوري، المدني والديمقراطي، محلّ قانون الطوارئ الذي ألغي مجاراةً للأجواء التي أشاعتها التظاهرات المسالمة والحاشدة، قبل استيلاء الإسلاميين “الجهاديين” عليها، وقبل ضلوع الحلقة الرئاسية، وإجراءات عفوها عن إسلاميي “القاعدة”، قبل “الدولة”، في الاستيلاء هذا.
ويحدد القانون بشكل فضفاض الجرائم المفترضة التي يعاقب عليها بعد أن يحيلها إلى محكمة مكافحة الإرهاب، وهي محكمة مستحدثة صدّق الأسد في نفس الشهر على قانونها الذي يحمل رقم 22، بديلاً من محكمة أمن الدولة العليا.
ولم يقلّص استبدال الطوارئ بمكافحة الإرهاب التعسُّفَ العرفي السائد منذ الانقلاب البعثي الأول.
“مكرمة سيد الوطن”
مرسوم العفو الجديد ليس الأول بل سبقته مراسيم مشابهة منذ عام 2011، ولكن معظمها لم يشمل “معتقلي الرأي والسياسيين والمشاركين في النشاط السلمي في بداية الثورة” وحراكها، في وقت شمل مرتكبي الجُنح والمخالفات والمخدّرات والسرقة والاحتيال.
ونبّه معاون وزير العدل، القاضي (الرسمي) نزار صدقني إلى أن المرسوم العتيد “لم يطلب أي إجراءات”، ولم يشترط على مَن يسري عليهم، ولا على أهلهم، “مراجعة الدوائر المختصة”. وعلى هذا، تتولى “مؤسسات الدولة (القيام) بالإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا المرسوم بشكل فوري” (وكالة سانا، 1/5).
ويبعث “كرم” السلطة الأمنية السورية، وتحميلها نفسها أعباء المراجعة والتحقق والإجراء الفوري، على الدهشة ربما، وعلى الشك من غير تردّد. وهي تكيل المديح لما أقدمت عليه، على لسان القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان. فيصف مرسومَ العفو- الصادر خلافاً للدستور الذي تحصر المادة 108 منه صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار عفو خاص، وتنيط المادة 75 العفو العام بمجلس الشعب وحده- بالـ”المنعطف القانوني الجريء”، ويعوِّل على “انتشالـ(ـه) الأشخاص من الجرائم (…) والانتقال بهم (…) إلى مسارات العلم والبناء وإعادة إعمار البلد (…) من خلال هذا التسامح الفريد…”.
ومشكلة الإجراء الذي يسمّيه حرس معتقل صيدنايا “مكرمة من سيد الوطن”، أنه يقع على ناسٍ لم يحصرهم إحصاء.
فإلى يوم الاثنين، في 9 أيار/ مايو الجاري، بلغ عدد المسجونين المسرّحين، بناءً للمرسوم الرئاسي العام، 960 معتقلاً وسجيناً من المحافظات السورية كلها. وبين هؤلاء من اعتُقل في الأشهر الأخيرة التي سبقت تاريخ العفو بشبهات جنائية لا تمتّ إلى “الإرهاب” في تعريفه الأسدي، بصلة، كما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان إطلاق سراح 27 معتقلاً وصفهم بـ”المنشقين”.
سرية العصابة
ومقارنة الألف معتقل المفرج عنهم اليوم، بنحو المليون معتقل الذين أحصاهم المرصد السوري لحقوق الإنسان (على وجه الدقة 969،854) منذ آذار/ مارس 2011، أو بالـ152،713 الذين لم يخرجوا من السجون والمعتقلات الأمنية و”النظامية”، ولا علم علنياً بمصيرهم- تُظهر هذه المقارنة ضآلة العدد الذي تُخرجه الأجهزة و”الأفرع” من زنازينها وأقبيتها وسراديبها.
وإنْ كان عدد مَن قُتلوا تحت التعذيب، وفي أثنائه، يُقدّر بنحو 105 آلاف، فإن عشرات الآلاف لا يزالون على قيد الحياة، ويصلحون “للتحرير”، على قول أنصار السجّانين والجلادين في أصحابهم ورفاقهم.
وتقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد المعتقلين “السياسيين” يبلغ 132 ألفاً، منهم خُطف من غير أثر إجرائي أو إداري، ولا “وجود” له.
وإغفال السجّانين والجلادين، أصحاب “المكرمة”، إعلان إحصاءات المسرّحين والمُفرج عنهم، وأبواب “جرائمهم” وارتكاباتهم، وتاريخ توقيفهم ومحاكمتهم ومُدد إدانتهم وتعريف الهيئات التي عُهد إليها بالمحاكمة، وتسمية السجون أو المعتقلات التي أمضوا فيها السَّجن أو الاعتقال- هذا الإغفال هو بمثابة إقرار بأن الهيئات التي تسن القوانين، وترسم المراسيم، وتنفذ الإجراءات، تعمل كلها، من حرسها وبوابيها إلى قضاتها ووزرائها، خارج الحق والقانون، وتنتهك شرع الدولة وعلانيته اللازمة والمُلزمة.
وتترتّب العلانية القانونية على مبدأ أول وأساس يقضي بألا يجهل أحد القانون، وبأن يعمّ العلم به كل مَن يطالهم القانون. وإلا لم تقع مسؤولية انتهاك على الجاهل. وانفراد إدارة السجون والمعتقلات السورية، على افتراض وحدتها ومركزيتها وجواز تسميتها “إدارة”، بمعرفة أبواب المُفرج عنهم، وسكوتها عن معرفتها، قرينتان على السرّية البوليسية والجُرمية والعصبوية (نهج العصابات) التي تطبع أفعال السلطة الأسدية بطابعها العميق.
هويّات مكتومة
وردّ السوريون على القرار الأمري، في صيغته السرية والأمنية، على نحو أبرز ثغرات القرار وانتهاكاته الصارخة، وضربه عرض الحائط بموجبات العلانية القانونية. فتجمهر مَن حسب أن الإجراء يعنيه، أو يطول أحداً يعنيه، في محلة أو منطقة جسر الرئيس في قلب دمشق، حيث محط معظم خطوط النقل الداخلي وملتقاها، وفي ساحتي صيدنايا، مدينة السجن الكبير والفظيع، وعدرا، المدينة الأخرى.
وحملهم على التجمهر في الأماكن الثلاثة إرادة السلطان حجب خروج المسجونين من سجونهم مباشرة، وقربها من السجنين الكبيرين والقريبين من العاصمة، وجهلهم بمَن يجيز المرسوم الرئاسي فك حبسه. ولما تخفّفت إدارة السجون والمعتقلات تعسُّفاً وتستُّراً من نقل المُفرج عنهم إلى حيث يقيمون، أو كانوا يقيمون حين اعتُقلوا أو أُوقفوا، وألقت تبعة النقل على عاتق المسرّحين ومَن قد تدعوه النخوة والمصادفة إلى نقلهم، خلص الأهل والأقارب المنتظرون إلى ترجيح قصد الطلقاء إما ساحتي صيدنايا وعدرا، وإما محطة السفر المركزية وعقدة المواصلات الداخلية.
وتعوِّل السلطات، وهي لم تتقيّد بتدوين إجراءاتها “القانونية”، على زعمها، ولا بعلانية التدوين المترتبة على صفة الإجراءات المشروعة، تعول على أثر السجن- ومدته، الطويلة على الأرجح، وعزله المسجونين وقطعه علاقاتهم وروابطهم بأهاليهم وجوارهم ودناهم الأليفة والأوسع- المرتقب في إضعاف انتساب المسجونين والمعتقلين إلى جماعة وعالم أو إطار يعرفانهم.
وترك السلطات البوليسية والعصبوية الطلقاء الجدد والمكتوميّ الهوية من غير مال يمكنهم من بلوغ منازلهم، ومن غير إعلان عن هويّاتهم، وإبلاغ أهلهم بإطلاقهم، دليل على توقّعها ضياعهم وتيههم حين خروجهم من عتمة السجن المادية والمعنوية، الحقيقية والمجازية، إلى “ضوء” السجن السوري الكبير، أو “الليل السوري”، على قول ميشال ديكلو، سفير فرنسا الأخير في سوريا عشية 2011.
شعب فاقدي الذاكرة
ويواجه طليق السجن السوري النظامي اليوم، أي في العام 2022، أحوالاً طرأت في العقد المنقضي، أو في نصف العقد على أبعد تقدير، غيّرت “وجه” وطنه وبلده وأهله وشعبه (إذا استعير “الوجه” للدلالة على التعريف والتعارف، وعلى التوجّه… إلى الوجه). وتتقدّم الأحوال الطارئة، والتغيّرات الجوهرية، حالُ الطليق نفسه، ومحله من تعريفه وهوّيته، ومن ماضيه وفصول سيرته، وبعضها فصل السجن وحوادثه.
فالمرصد السوري لحقوق الإنسان- وهو أولى المنظمات المدنية التي تُعنى بعلانية إحصاءات الوقائع السورية الوطنية، ونقيض “الدولة” السرية والخفية الرسمية- يقول إن قسماً كبيراً مسرّحي العفو العام الأخير فقدوا ذاكرتهم. ولا تستقيم هوّية إنسانية، فردية أو شخصية واجتماعية، بغير ذاكرة حية تؤرخ الانفعالات والأهواء والأواصر، وتنسب الأفعال، وتجمع الناس وتفرّقهم وتُدرجهم في أبواب وسياقات، و”تلحم” الأشياء.
ومَنْ هذه حالهم، أي فقدوا ذاكرتهم، قلّوا أو كثروا، في وسع السلطات، الأمنية “المخابراتية” منها على الخصوص، أن تأمن جانبهم، وتنساهم على نحو نسيانهم هم عالم الإنسيين. ويقوم “شعب” فاقدي الذاكرة (السوريين) مقام الكناية عن “الشعب السوري” الصالح واللائق بـ”مكرمات سيد الوطن”، وأسياد الأوطان من أمثاله.
وكانت حنة آراندت (1906- 1975)، الألمانية-الأميركية وصاحبة “أصول الكليانية”، قد جرّدت التوتاليتارية أو الشمولية من طلب احتكار السلطة المطلقة. وقدّمت على طلب الاحتكار السعي في حل الأواصر الإنسانية والاجتماعية، وذاكرتها، بين البشر. فلا يستوي سلطان أو يتربّع على كرسي “الأبد”، بحسب الشعار الأسدي المتوارث ولداً عن والد، ما تشاركت “رعيةٌ” رابطةً معنوية يتوجه بها إنسي على آخر.
غربة العالم
وعلى المُفرج عنه، ومالك ذاكرته، أن يقصد “أهله”، أي رهط مَن يفيء إليهم ويلوذ بهم، ويضوونه أو يجمعونه إليهم ومعهم. ومن خاصيات الحال السورية، في ظل “الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وتحريره لمعظم الأراضي السورية من دنس الإرهاب” (نزار صدقني، معاون وزير العدل السوري)، أن الخارج من السجن أو الاعتقال قد لا يجد مَن ينزل فيهم أهلاً، ويحل سهلاً، على معنى الترحيب بـ”أهلاً وسهلاً”.
فهم إما قُتلوا، في عداد الخمسمئة ألف قتيل الذين قصفت الحروب السورية الأهلية أعمارهم. وإما سُجنوا ولم يقضوا في سجنهم بعد، ولم تشملهم مراسيم العفو، ونُسوا. وإما خسروا منازلهم أو حاراتهم أو بلداتهم أو قراهم التي دمّرتها الحروب المتنقلة والمتسلسلة. فاضطروا إلى النزوح داخل سوريا، واستيطان بلاد أخرى غير مساقطهم، وامّحت الآثار التي تدلّ عليهم وتقود إليهم. وهم ألوف مؤلّفة، أي ملايين. وإما غادروا إلى المنافي “الهانئة” أرضاً ملعونة سُلط عليها هلاكها، على تشخيص قرآني معروف. فانقطع ما بينهم وبين ذويهم. فجهل ذووهم ما حل بهم، ولم يدروا هم ما صار إليهم ذووهم.
فالخيوط التي تربط المعتقلين، المسرّحين والمقيمين في الاعتقال، بغير المعتقلين ذاوية، ولا تصلح للاستدلال بها على واقعة أو قرينة. وجمهور المنتظرين اليوم طليقاً أو طليقة إنما يرجمون في الغيب. فهم لا يعلمون إذا كان مَن ينتظرونه حياً أم ميتاً، ولا متى فارق الحياة إذا صح أنه قضى، ولا كيف قضى وأين دُفن… ولا يعلم معظمهم في أي سجنٍ سُجن صاحبهم، ولا الوقت الذي قضَّاه في سجونه.
ولما نزل المسرّحون الأوائل من السيارات التي أقلّتهم إلى ساحتي صيدنايا وعدرا، وإلى جسر الرئيس، تهافت عليهم، فوق تهافت أهلهم أو مَن يمتّون إليهم بقرابة أو آصرة، مَن يريدون سؤالهم عن قريب، أو نسيب، أو رفيق انقطعت أخباره وآثاره منذ سنين، طويلة غالباً. ولا سبيل إلى تعقُّب أثره إلا عرض صورته القديمة، وفي قيافة بائدة، حائلة اللون ومحفوظة في ذاكرة سمارت فون عتيق، على طليق مرهق الذاكرة، في خير الأحوال، وفاقدها في شرها.
وعلى شاكلة الطلقاء الذين تقوم أعوام السَّجن وجلجلته حاجزاً بينهم وبين مَن يعودون إلى دنياهم المختلفة، فيعشى بصرهم ويرون الناس “الأحرار” ظلالاً أو أطيافاً، يتساءل مستقبلو المفرج عنهم، سكان العالم العادي، عن طاقتهم على التعرُّف على “العائدين”. وترجو الواحدة، زوجة أو أختاً، صاحبتها أن تتلقاها حين يغمى عليها لا محالة وهي تتعرّف على مَن تنتظر، ويقرّ في روعها أنه هو، أو أنها هي، أو أنهم هم (“أنتظر أولادي الخمسة وزوجي منذ العام 2014. لقد سلّمتهم إلى ربي”، تقول واحدة من النسوة المنتظرات).
والصمت المُطبق الذي لفّت به السلطات السرية والبوليسية السورية، وحواشيها الأهلية والمرتزقة، الاعتقال والمعتقلين، نصَّب طبقة من الانتهازيين والسماسرة والطفيليين وسطاء بين الأجهزة وبين أهالي عشرات آلاف “المغيّبين”. فجعل تكتّم السلطات، أو جهلها ولا مبالاتها بمَن تقتل أو تعطب أو تشرّد أو تسكت عنه، من فتات معلومات هذه الطبقة سلعة تجارية.
فيشتري الأهل الخبر عن المعتقل، أو صنف الخبر (تاريخ التوقيف، مكانه، محل الاعتقال، اسم المسؤول المباشر عن المعتقل…)، لقاء ثمن. ويقتضي تتبّع الخبر أو جزئه، ثمناً آخر يجر ثمناً… ويكتمل الشبه بين عالم المعتقلات السوري، النظامي، وبين “عالم الحياة”، العادي والعادية، في “دولة” تُساس على شاكلة سوس أو سياسة العصابة مسرح القطاع الذي اقتطعته أو أقطعته.
رصيف 22
————————–
الاستبداد السوري والعدم البعثي/ عمر الشيخ
كان صمت الضحايا أكثر ما يهزّ كيان الإنسانيّة خلال تسريبات توثيق مجزرة حيّ التضامن في دمشق، ويقابل ذلك سيل جارف من تبرير القتل لدى موالاة نظام الأسد، إلى جانب دوّامة مقارنات العنف خاصتهم، من باب “ونحن لدينا مجازر ارتكبتها المعارضة”، وكأنما تعيش المقتلة السورية في مباريات الولاء العقائديّ وتنظيم المجتمع في صفوف وحوشٍ مؤجّلة؛ أكانت وحوشاً بالمجاز المعنوي والفكري أم كانت تدافع باستماتة عن رموزها التي تقود وعيها وعقلها وعواطفها، وتجد لها الأسباب والدوافع “المقنعة”، برأيهم، لفعل القتل!
كان الصمت أشدّ ما يلفت الكائنات التي ما زالت تحمل صفة البشر، ولديها من التعاطف الفطري ما يقيها من مراحل شرعنة سلب أرواح الناس لأيّ سببٍ كان، ليس بداية بالاختلاف السياسيّ والمواقف من الأحداث الدامية في بلادي، وليس انتهاءً بالتنوّع الواسع في مجتمع معقد دينياً وطائفيّاً مثل سورية، وأقول هنا “معقداً” لأنّ نظام “البعث العسكري” الذي يحكم البلاد بالحديد والنار لم يُقِم أي اعتبار للعمق التاريخيّ والثقافيّ والدينيّ والاجتماعيّ الموجود في الموروث السوريّ الغنيّ، الذي تجاوز بالتجارب تحدّياتٍ كثيرة على مستوى الحرية والمعتقد والثقافة والسياسة، وجعل (النظام) تلك التعدّدية أداة تفرقة يستخدمها ضد الطوائف والقوميات، بل ويدفع بشراً من البلاد نفسها، ولأسباب انتقاميّة، إلى أن يسوقوا بضعة مدنيين من حواجز أمنية على أطراف دمشق، وينتزعوا منهم أرواحهم بالرصاص والنار بمنتهى الصمت.
يدفعني التفكير كثيراً بالشعارات التي شحنها نظام الأسد في مخيّلة المراهقين عبر حصص التعنيف المسمّاة “تربية عسكرية”، والتي أستحضر منها جملة “نفّذ ثمّ اعترض”، تلك الكلمات المقفولة تماماً عن أيّ فرصةٍ للحياة، للتفكير بجدوى الاعتراض على أفعالٍ وقراراتٍ قد تُفقد المرء حياته، وهذا بالضبط ما شعرت به، بينما رأيت جنود جيش الأسد يعصبون عيون مدنيين ويكبلون أيديهم، ويطلبون منهم التقدّم باتجاه حفرة الموت، بينما تخترق أجسادهم رصاصاتٍ دفعوا ثمنها من تعبهم ولقمة أولادهم. هكذا، يمضون، لا شيء يعترضهم سوى الصمت المدفون مع إطارات السيارات المستعملة، شريكة النار فوق أجسادهم، شريكة تخفي بسوادها ودخانها هوية الرائحة وآثار المجزرة.
تمثل شعارات الاستبداد السوري نظرة بانورامية على الطريقة الآليّة التي يعمل عليها نظام البعث في المجتمعات السورية. والإشارة هنا قصداً إلى مفهوم “المجتمعات”، لأن معدلات الاختلاف الاجتماعيّ بين شمال سورية وجنوبها تكاد لا تُصدّق لشدّة اختلاف اللهجات المحكية مثلاً، وفهم الدين والتجارب السياسية والعادات والتقاليد وقراءة التاريخ .. إلخ، إلا أن إعادة تنميط المناطق والتغيرات الديموغرافية المستمرّة جعلت القاسم المشترك لدى السوريين جميعهم تقريباً هو الخوف من الاختلاف والاعتراض، وتلقّيهم الأحكام الجاهزة بالتخوين والعمالة لأيّ فكرٍ يرفض الاستبداد والطغيان وعسكرة السياسة وتبرير قتل الآخرين.
ولم تكن تلك الجُمل الراسخة في عقول ملايين الأطفال عن “أبوّة القائد” مجرّد تدريبٍ على التبعية وتغييب العقل وإنكار الذات، إنما أصبحت أساليب حياةٍ ونظرة إلى أهداف العيش، وكيف سوف تكرّس مقام “أبوّة الأسد” وإطلاق مبادئ “الأبد البعثي” وأولوياته على الشعب، بوصفه يخدم راحة القادة ومسؤولي “الدولة” ضمن تصنيفٍ طبقي أنتجه كل هذا الحقد بين أفراد المجتمعات في سورية، وسببها الأساسيّ تركيبة هذا النظام الطائفيّ والعنصريّ. وبالعودة هنا إلى مجزرة “حي التضامن”، نعلم تماماً أن ذلك الحيّ كان يقوم على طبقات متوسطة الحال، ومن أطياف ومذاهب مختلفة ومقسومة الأفكار على فهم العدالة والحقوق والحريات، ولكنها لم تكن، في أي حال، تتعايش معاً، فمن وقف إلى جانب الاحتجاجات جرى فرزه وإعلان موته، ولو بعد حين، ومن بقي ولاؤه للأسد، حتى لو قتل العشرات، سوف يتم تسليحه وضبط طاقته الإجراميّة لخدمة الرعب وإرهاب الناس بحدود ما تريده السلطة. أمّا هؤلاء الذين كانوا يمعنون بسكوتهم وهم يُجرّون إلى مواجهة الإعدام، فإنهم لم يكونوا يوماً إلا سوريين، مثل مئات آلافٍ لم تستوعب آلة القتل في سورية تفهّم أن لديهم رغبة في حياةٍ كريمةٍ من دون طغيان وعسكر.
القيم الإنسانية النابعة من فهمنا البسيط للتعاطف مع المستضعفين من أبناء جنسنا، إضافة إلى الانفعال والرعب أمام مشاهد سلب أرواح الناس والاعتياد القاسي على رؤية مشاهد دماء البشر ودمار المدن، هي قيمٌ تؤلم المجرمين، تجعلهم يشعرون بدنوّهم الحيواني القائم على نظرة العدم البعثي، نظرة الغاب والبقاء للأعنف، البقاء للشعب الذي اخترع شعارات أيضاً مثل “يا بشار لا تهتم عندك شعب بيشرب دم”. بالضبط، هذا ما كان يريده النظام، جعْل الناس تستبدل صفاتها البشرية بصفات وحشيّة، حتى ترى القتل والتعذيب والاعتقال والتنكيل بالجثث أموراً طبيعية، في بلد تعبت على بنائه الماكينة العسكرية، لجعله بهذا الشكل من الفقر والتهجير والمجازر والاستخفاف بحياة السوريين، لعل الأكثر سخريةً مما يمكن تذكّره، هو التخلص بسهولة، أيضاً، من أزلام النظام مهما كان شأنهم ودورهم وجرائمهم وخدماتهم؛ مهمّة بالنسبة للنظام، يكفي أن نتذكّر تفجير خلية الأزمة عام 2012 المفتعل، حسب التحقيقات المستقلّة، وكذلك التخلص من أشخاص بوزن غازي كنعان، رستم غزالي، عصام زهر الدين، بنهايات دراميّة مكشوفة.
إنهم يخترعون طرقاً رهيبة لقتل الآخر، ويعلّمون الأجيال عليها، ينفون عن الأطفال صفة الطفولة، ويحوّلونهم إلى جنود يفدون القائد مهما حصل وكيفما يمكن من وحشيّة. يضحكون على سقوط الضحايا في حفرة الحرق، فقط لتكريس الردّ بالعقاب لكل من ينوي (مجرد نيّة) ألا يكون قاتلاً ويعترض على موته.
مهما دخلنا وقاربنا وحاولنا تفكيك الذهنيّة الأمنيّة التي مضى عليها أكثر من نصف قرن، راسخة صلبة ومدعومة من دول أجنبيّة بالسلاح والتعويم، سوف نحتاج إلى وقتٍ طويل للغاية لنزيل من الوعي العام كلّ آثار تبرير الاستبداد والعدم الذهنيّ المزروع في مئات آلاف السوريين الملوثين بتقديس البعث أو الأسد؛ إذ لا فرق بينهما.
العربي الجديد
——————————-
اعترافات بشار الأسد.. قراءة موازية في مرسوم العفو/ عبد القادر المنلا
إن لم يكن ثمة أية أسباب للثورة في سوريا، فيكفي مرسوم العفو الأخير سبباً جوهرياً لها، ليس فقط بسبب سخريته من السوريين والتلاعب بهم ورقصه على عذاباتهم وفوق جثث ضحاياهم، بل لسبب يعود إلى ما هو أبعد بكثير.
إن تعاملنا مع مرسوم العفو على أنه مجرد كذبة سياسية وتحايل وحدث زائف يمكن مناقشته ونقد تفاصيله والسخرية منه، أو أنه مجرد رد على مجزرة التضامن للتخفيف من تبعاتها على رأس النظام، فسوف نحقق ما يريده الوريث وما يصبو إليه، ونكون من جديد ضحايا الفخ الذي يريد أن يجرنا إليه، فهذا المرسوم لا يمكن التعامل معه إلاّ على أنه دليل إثبات على ما هو أكبر من مجرد جرائم ضد الإنسانية، وأبعد من مجرد دعاية لرأس النظام..
ثمة توجه ملحوظ يحاول النظام في سوريا ترسيخه والتعامل معه على أنه واقع، وهو فكرة “تأليه الرئيس” استناداً إلى فكرة تبدو في ظاهرها إنسانية بحتة وهي فكرة العفو والصفح.
ويمكن إثبات ذلك النزوع إلى تأليه الرئيس من خلال مجمل الخطاب الذي فرضته الأجهزة الأمنية على السوريين منذ بداية الثورة، حيث أطلقت تلك الأجهزة تسمية “سيد الوطن” على بشار الأسد لتأكيد تلك الفكرة بالقوة وإجبار السوريين على قبولها والرضا بتصنيفهم كعبيد لذلك السيد، كما تم اعتماد كلمة “الرمز” على بشار الأسد بشكل تجاوز فكرة القائد الرمز التي تم إطلاقها على أبيه، ودأب رجال الدين المقربون من السلطة على المقارنة صراحة بين بشار الأسد والأنبياء، ثم بينه وبين الإله، بعد أن كانت تتم مداورة في عهد الأب، في محاولة مفضوحة وصفيقة لإضفاء صفة “الذات” على الرئيس وسلخه عن مرتبة البشر ليحتل مكان الآلهة..
كما أن تسلسل الأهمية (الله وسوريا وبشار) والذي ساد كشعار للمسيرات المؤيدة منذ العام 2011، قد انقلب الآن ليتم التركيز فقط على “بشار”، وإسقاط ما عداه في معادلة الأهمية..
ومن هنا لا تتوقف فكرة العفو عند حدود تصدير صورة الرئيس المتسامح، المحب، الحريص على وطنه ومواطنيه وعلى مفهومي الصلح والسلم فحسب، بل تمتد لتؤكد ذات التوجه وترسيخ فكرة “الألوهية” التي ابتدأت مع حالات العنف الشديد التي اعتُمدت في موجات الاعتقال الأولى، حيث كثيراً ما سرب النظام فيديوهات لحالات تعذيب المعتقلين وهم يُسألون: “مين ربك ولاه، قول ربي بشار الأسد…إلخ”، وهو ما يصب في ذات الهدف الذي يسعى إليه النظام..
في هذا الإطار وحده يمكن أن نفك أحد أهم رموز الرسالة المشفرة التي يحملها قرار العفو، صحيح أن ثمة رسائل أخرى أهمها تأكيد الرئيس على أنه ما يزال ممسكاً بقرار حياة السوريين وموتهم، وتأكيد هيمنته المطلقة سياسياً وعسكرياً وأمنياً، وإعلاء انتصاره، ولكن البعد الآخر والمتضمن فكرة التأليه لا يجب أن يغيب عنا، والهدف من ذلك ليس خنق الثورة وحسب، بل قطع دابر التفكير في التمرد على الرئيس وسلالته من بعده أيضاً، وبحيث يعود الحكم الأبدي ليكون إحدى البديهيات غير القابلة للجدل في قادمات الأيام، ولا سيما أن الأسد وأتباعه باتوا اليوم على يقين من قدرتهم على تأسيس سلالة حاكمة يكون أهم شروطها وأركانها تثبيت صفة الألوهية على تلك السلالة ونزع كل صفات البشر عنها، في محاكاة واضحة لتجربة السلالة الحاكمة في كوريا الشمالية..
لا يحتاج الأمر إلى كثير عناء لنعرف أن مفهوم العفو يحيل إلى شأن شخصي لا علاقة له بالسياسة، فأن تعفو عن أحد يعني بالضرورة أن تسامحه بعد أن ارتكب خطأً شخصياً بحقك، فمن يخرج من المعتقل بعفو من الرئيس يعني بالضرورة أنه دخل المعتقل بسبب غضب الرئيس عليه، وفي المرسوم الأخير الخاص بالعفو اعتراف بأن المعفوّ عنهم هم أولئك الذين غضب منهم الرئيس حينما أعلنوا رفضهم له، فتم اعتقالهم بسبب إساءتهم للذات الرئاسية لا بسبب أذية للوطن، أرادهم الرئيس مدانين فتمت إدانتهم، أرادهم الرئيس إرهابيين، فتم لصق تلك التهمة بهم، ثم قرر الصفح عنهم، فكان قرار العفو، والذي رغم كل كذبه وزيفه وابتزازه للسوريين، ما هو إلا صفح شخصي عن تلك “الإساءات”، الأمر الذي ينفي أي بعد وطني أو سياسي عن الاعتقالات والعفو معاً، وهو ما يؤكد شخصنة الموضوع برمته وإحالته إلى مزاجية الرئيس، الأمر الذي يبرئ المعتقلين ويدين من اعتقلهم.
وبصرف النظر عن تفاصيل المرسوم الذي أصدره الجلاد بحق ضحاياه، وبصرف النظر عن المشهد الذي أعقب صدور القرار، والذي تجمع فيه الآلاف ممن لهم مفقودون ينتظرون خبراً عنهم منذ سنوات طوال، وبصرف النظر عن أن قرار العفو بحد ذاته كان شاهد إثبات على المجرم والإرهابي الفعلي الذي ارتكب جريمة العصر بحق السوريين وما يزال، فإن اللغم النفسي الذي يحاول النظام زرعه في قلوب السوريين وعقولهم، سيكون واضحاً تماماً لكل من يحاكم المشهد محاكمة عقلية بعيداً عن العواطف والانفعالات والمشاعر الجياشة..
يكاد الرئيس يقول خذوني، هذا هو حال بشار الأسد بعد مرسوم العفو، لا علاقة وثيقة لتوقيت إصدار المرسوم بالفيديو الذي تم تداوله عن مجزرة التضامن كما يعتقد الكثيرون، فبعد عقوبة استخدام الكيماوي والتي اقتصرت على تجريم السلاح وتبرئة مستخدمه، وبعد قانون قيصر الذي لم يسبب أذية حقيقية للنظام، وبعد آلاف الجرائم والمجازر التي لم تسفر عن أي إجراء حقيقي ضد الأسد، لم يعد الأخير يأبه بالمجتمع الدولي ولا بردود أفعاله التي يعرف جيداً أنها لن تتعدى بعض التصريحات، ثم تنطفئ جذوتها بالتدريج.
لا علاقة للعيد أيضاً بمرسوم العفو، فأفراح الناس ومناسباتهم لا تهم الأسد في شيء، كل ما في الأمر أن الأسد يريد المضي قدماً في ترسيخ فكرة الرئيس الإله، وهنا بالضبط موضع إدانته ليس بوصفه متجرئاً على الدين، بل بسبب تجرّئه على تثبيت فكرة أنه أهم من الوطن وأهم من الشعب، ومرسوم العفو يأتي دليل إدانة صريحاً في هذا السياق..
ليس ذلك الكم من المتجمهرين والذي يعطي مؤشراً واضحاً على أعداد المعتقلين، ودليلاً آخر على ابتزاز الناس وتجيير عذاباتهم من أجل تبييض صفحة الرئيس، ولا الفضيحة المدوية التي شاهدناها من خلال حالة المفرج عنهم والذين خرجوا كجثث متحركة بعد أن أفقدهم التعذيب كل مقومات الإنسان، كل ذلك ليس سوى القشرة الخارجية لأدلة الإجرام، فالدليل الأهم هو مرسوم العفو نفسه، الذي يحمل إدانة واضحة للرئيس ليس فقط فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها خلال أحد عشر عاماً، بل بالجريمة الأهم وهي جريمة ادعاء الألوهية والقبول بتأليهه من قبل أتباعه ومؤيديه، جريمة السماح لأولئك الأتباع بأن يفعلوا ذلك، إنها جريمة تشويه الإنسان والعبث بالقيم، وتجريف البنية الأخلاقية، جريمة التضحية بالوطن والشعب معاً من أجل شخص يريد البقاء على كرسي الحكم ولو شكلياً دون قرار سيادي ودون أي صلاحيات تتعلق بالمصالح العليا للوطن، ومن أجل المحافظة على مهمة قتل السوريين وتنفيذ أجندات الدول الداعمة للرئيس ومصالحه الخاصة.
لقد اضطر كثير من السوريين للتعاطي مع أمر يثير السخرية، كقرار العفو، بشكل جاد، فعلى الرغم من كاريكاتورية الموقف حينما يعفو الجلاد عن الضحية، وعلى الرغم من الكذبة المفضوحة في كل ما يتعلق بهذ العفو، إلاّ أن المرسوم شكل أملاً للكثيرين ممن ينتظرون بفارغ الصبر خبراً عن مفقوديهم، قبل أن يكتشف هؤلاء أنهم راحوا ضحية خديعة جديدة من خدع الأسد، وأن هدف الرئيس هو تصدير نفسه على الهيئة التي يرتئيها وليس التعاطف مع المظلومين الذين فقدوا سنوات طويلة من عمرهم، أو فقدوا حياتهم كلها عندما أراد الرئيس ذلك.
عرفت دول العالم ظاهرة العفو، ولكنها تتم من خلال إجماع حكومي ولظروف مختلفة تماماً عن ظروف الاعتقال في سوريا، ويكفي هذا المرسوم وراسمه ذلاً أن أحداً من السوريين لم يصدقه، ولم يعره أي قيمة، ما يؤكد غياب الدولة واستبدالها بشخص، وما يعني أن أسباب الثورة في سوريا باتت ملحة أكثر من السابق..
تلفزيون سوريا
———————–
النظام يلمّع عورته/ محمد العبدلله
أعطوني واحداً، رُدُّوا لي واحداً فقط، أكحل عينيَّ برؤيته قبل أن أموت، لي ستة في السجن، ستة…، أريد واحداً… بهذه الكلمات كان يجهش العجوز، وهو ينتظر عبثاً أن يرى أحد أولاده يخرج من السجن… كلمات ينفطر لها القلب وتتمزق الأحشاء.
عشرات مثل هذا العجوز ينتظرون، ويروون قصصهم تحت جسر الرئيس وسط العاصمة السورية دمشق، يتسامرون فيما بينهم، فيروي كلُّ واحد للآخرين مأساته وحكاية أسرته مع معتقلات النظام لعلَّه يخفف عن المستمعين عندما يعرفون أنَّ ثمَّة قصَّة أشدَّ إيلامًا من قصتهم.
المشهد مأساوي وتفاصيله تعكس مدى البؤس الذي وصل إليه السوريون وما آلت إليه أحوالهم، والذل الذي يكابدونه في ظل حكم نظام العائلة الأسديَّة الذي يبدو أنه لا يرتوي من قتل الناس وإذلالهم.
لكن ماذا لو سلك النظام مسلكاً آخر غير الذي تابعناه في عملية إطلاق سراح المعتقلين، واحترم بعضاً من إنسانيتهم وإنسانية ذويهم، كأن يبلغ أهالي المعتقلين قبل عملية إطلاق سراحهم، ويحدد تاريخ بدء العملية وتواريخ وصولهم إلى محافظاتهم، أما كان يمكن له أن يلمِّع صورة بعض الشيء؟
ولو افترضنا أنه أراد ذلك، فهل كان يستطيعه؟ إنَّه لا يستطيع بالتأكيد، ولن يستطيع، ذلك لأن طبيعة تكوينه الأقلّية لن تسمح له بذلك، ولسبب آخر هو أن هذه العصابة التي تحكم البلد منذ أكثر من نصف قرن، إنما تحكمه بطريقة عشوائية، لا تستند إلى أية أصول أو أية مبادئ أخلاقية في طرق الإدارة وأساليب الحكم، ولا تعرف سوى العنف المفرط في مواجهة أي حركة احتجاجية شعبية كما حصل في بداية ثمانينيات القرن الماضي – “مجازر حماة ومجازر سجن تدمر ومجزرة حي المشارقة بحلب ومجزرة جسر الشغور وغير ذلك من المجازر”.
وبما أنَّ عصابة الحكم الأسدية لم تواجه أية عقوبات جدية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولم تواجه أي شكل من أشكال الردع الحقيقي فقد تمادت في طغيانها، واستمرأت سلوكها العنفي البعيد عن أيِّ مبدأ أخلاقيِّ.
ربما كان من شأن موقف دولي جاد حيال ما ارتكبه النظام من مجازر أن يدفعه للتفكير قليلا قبل أن يقدم على تنفيذ محارقه بحق السوريين، إلا أن اطمئنانه على ما يبدو إلى عدم العقاب والنجاة من تبعات جرائمه منذ أيام حماة وحتى اللحظة الراهنة، إضافة إلى الدعم شبه المطلق من حليفيه الروسي والإيراني، هذا الواقع ربما غير المسبوق في العلاقات الدولية شجع العصابة الأسدية على استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري غير مرة وفي عدَّة أمكنة، وقد اتضح بعد تنفيذه جرائم استخدام السلاح الكيماوي أن هذا النظام هو بالفعل في مأمن من أية عقوبات جدية، لا بل إنَّه رأى في تساهل المجتمع الدولي بصمْتِه عن تلك الجرائم الضوء الأخضر للاستمرار في نهجه الإجرامي، والإصرار على إهانة السوريين وإذلالهم.
وبالعودة إلى مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام مؤخرا وبالنظر إلى دلالات توقيته، يكاد يجمع خبراء القانون والمحللون وحتى الأشخاص العاديون على أن التوقيت مرتبط ارتباطاً مباشراً بمجزرة حي التضامن. وفي هذا السياق قال الخبير القانوني السوري عبد الناصر حوشان في حديثه لصحيفة القدس العربي اللندنية: “إن هدف النظام السوري الخبيث من إصدار المرسوم في هذا التوقيت بالذات هو التغطية على الضجة الكبيرة التي أحدثتها مجزرة حي التضامن، والتي تعتبر جريمة حرب تم تصويرها لحظة ارتكابها على يد أحد المتنفذين لدى النظام السوري المعروفين بسوء صيتهم” واعتبر حوشان “أن التعاطي مع المرسوم رقم 7، على أنه قانون عفو عام مقاربة خاطئة ومغالطة لا يجب تمريرها ” عازياً السبب إلى أن قوانين العفو العام تكون شاملة وتكون مفصلة، بينما القانون رقم /7/ جاء بصيغة العموم ولم يفصل الجرائم والمواد المشمولة به” وأضاف حوشان، ” أن القانون اتُّخذ بشكل عاجل بدليل أن محكمة الإرهاب تعثرت في عملها، فهي ليس لديها معلومات بموضوع المرسوم، بدليل البطء الواضح في تنفيذ عمليات تشميل الجرائم وإطلاق سراح المعتقلين” لا شك أن إطلاق سراح عشرات المعتقلين مؤخرا قد أنعش آمال ذوي المعتقلين والمغيبين قسرياً وهم قطاع واسع من السوريين، إلا أن المعطيات التي توفرت حتى الآن تقول إن معظم من أفرج عنهم حتى الآن هم من معتقلي التسويات الذين زُجُّوا في السجون في الفترة الممتدة منذ /2017/ وحتى الآن، ولم يتجاوز عددهم بضع مئات معظمهم من محافظتي درعا ودمشق. إضافة إلى أن من بينهم معتقلين أو محكومين بتهم جنائية، وفيما يتصل بمصير عشرات آلاف المعتقلين والمغيبين قسريا الذين ثبت بالأدلة القاطعة أن النظام اعتقلهم منذ بداية الثورة، يقول أحد خبراء الأمم المتحدة في ندوة ناقشت وضع المعتقلين في سوريا: إن معظم هؤلاء قد تمت تصفيتهم بعد محاكمات صورية وفق ما يسمى بقانون الإرهاب الذي أصدره النظام في تموز عام /2012/ بعيد اندلاع شرارة الثورة ليغطي على جريمة تصفية آلاف السوريين الذين اعتقلهم بذريعة مكافحة الإرهاب واقتصرت تلك الاعتقالات كما بات معروفا على مكون الأكثرية في المجتمع السوري مما مهد الطريق حسب كثير من المراقبين لتنفيذ جريمة لا تقل خطورة عن جرائم الاعتقال والتغييب القسري وجرائم القتل بوساطة السلاح الكيماوي والصواريخ والبراميل المتفجرة والتهجير داخل وخارج سوريا، تمثلت في جريمة التغيير الديمغرافي التي طالت العديد من المناطق ذات الغالبية السنية لا سيما في شرق سوريا التي أصبحت في معظمها تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية.
في الخاتمة:
كان يفترض أن يكون عنوان هذا المقال “النظام يلمع وجهه أو شكله أو أي شيء آخر يمكن تلميعه”، لكنَّ تاريخ هذا النظام الإجرامي أثبت لكلِّ العالم أنَّه لا يمتلك شيئًا قابلًا للتلميع، فهو عورة صرف، وسوءة خالصة، وليس لديه ما يلمعه غير ذلك، حتى لو أصدر عشرات مراسيم العفو.
————————–
في الهولوكوست السوري.. المجرم شاهد على نفسه/ وفاء العلوش
لا يمكن للمرء أن يخلق دليلاً لنفسه، قاعدة قانونية متعارف عليها في القوانين والتشريعات، لكن ذلك لا يمنع أن يخطئ المجرم ويتورط في الاحتفاظ بأدلة تدينه، وقد يستمر بالعودة إلى مسرح جريمته مراراً وتكراراً.
المجرم في القضية السورية لم يحتفظ بالأدلة عن طريق الخطأ وإنما من باب المفاخرة بهزيمة الطرف الآخر، إنه لم يغادر مسرح جريمته ولم تزعزعه المحاولات المختلفة لإزاحته، منذ اندلاع الثورة السورية مروراً بالمآسي المختلفة التي عانيناها كسوريين لإثبات أحقيتنا في التمرد ضد طاغية وسفاح لم يشهد العصر مثله.
لم يأخذ القَتَلة في سوريا فترة استراحة كانت الأفرع الأمنية والآلة العسكرية مستمرة بالتنكيل في الناس والجثث من دون كلل، فيما كان البقية يُهجرون ويُعتقلون من دون حساب، فلم يكن منا في مواجهة التخلّي العالمي عن دعم الثائرين، وتحت وابل الصواريخ والبراميل التي تستهدف المدنيين وبعد النزوح من آلة القتل السورية وشركائها، سوى أن نلجأ إلى جمع الأدلة وتوثيقها وتوثيق أسماء المعتقلين والشهداء والمفقودين لغاية تقديمها للمحاكم المختصة لتكون بارقة الأمل الأخيرة في سبيل تحقيق العدالة.
كان ذلك استحقاقاً رئيساً بعد أن جهدت وسائل الإعلام والمنظمات على تشويه صورة الثورة وتحويلها إلى حالة حرب داخلية ونزاع أهلي، وإسقاط صفات الثورة ضد الاستبداد عنها في محاولة لإلباسها ثوب الحرب الأهلية، بحيث يتساوى الأطراف وتنتفي أحقية المطالب السياسية والإنسانية التي خرج السوريون لتحقيقها.
في الوقت الذي جهد الناشطون ومكاتب التوثيق للبحث عن أدلة تدين الأسد والأجهزة الأمنية المتورطة في دم السوريين لجمعها وتقديمها للمحاكم الدولية بهدف الانخراط في مسار قانوني يحقق العدالة ولو بجزء منها، كانت عناصر هذه الأجهزة توثق جرائمها وكأنها في احتفالية نصر ويتناقلونها ويعيدون مشاهدتها بفخر ونشوة من دون أدنى اعتبار لما قد يحصل لو أن تلك الوثائق وصلت إلى يد الطرف الآخر.
قد يبدو سلوك المجرم الذي يوثق جريمته مرَضيّاً وبحاجة إلى تحليل علم نفس المجرم للتأكد من سلامته العقلية والنفسية، لكن الأمر هنا يبدو مختلفاً إذ يبدو وكأن المتورطين في عمليات القتل والتعذيب واثقون من قدرتهم على الإفلات من العقاب، ما يمنحهم الجرأة في أن يرتكبوا مثل تلك الفظائع، فلا يتوانون عن إطلاق خطاب كراهية والدعوة إلى تجريد من يخالفونهم الرأي من جنسيتهم، أو توزيع شهادات وطنية أو سحبها بحسب ما يناسبهم، ولا يوجد رادع يمنعهم من الذهاب إلى الحدود القصوى في تعذيب خصومهم.
الروايات التي يعرفها الباحثون والمهتمون والرأي السوري العام عن ممارسات الجهاز الأمني والتشكيلات التابعة له مع المعتقلين، تشي بكم الوحشية المتعمدة في أقبية الموت، فأولى ممارسات التعذيب وأخفها وطأة أن يجعلوا المعتقلين يستمعون إلى صرخات المعتقلين الذين يعذبون في غرف أخرى، لمحاولة التأثير نفسياً عليهم، ثم تتدرج المراحل حتى الوصول إلى أقصاها.
يبدو استخدام التعذيب أمراً منهجياً في المعتقلات السورية أو خارجها وليس سلوكاً فردياً أو حدثاً قد يحصل مصادفة، كما يبدو انتفاء وصف التعامل الإنساني بداية منذ منح المعتقلين أرقاماً بدلاً من أسمائهم، وقد يتمادى المحققون بحيث يجبرون المعتقل على قتل الآخر وحمل جثته لدفنها أو حرقها في مكان ما.
وإذا أردنا تكثيف الفكرة فالنظام السوري لا يهتم بأنه من باب الحكمة بألا يحتفظ الجاني بدليل على هذه الجريمة التي اقترفها، بل قد يتعدى الأمر ذلك بحيث يفاخر القتلة بكم الجرائم التي اقترفوها وقد يعتبرونها معيار بطولة، حتى أنهم مرتاحون بفعل القتل والتعذيب وكأن العالم قد منحهم رخصة لاقترافها وحصانة ضد العقاب بسببها.
لم تغير كل الوثائق والمستندات المرئية والمسموعة التي جمعتها مكاتب التوثيق من سلوك العالم تجاه القضية السورية كما لم تجعل المجتمع الدولي يتخذ قرارات حاسمة تجاه سفاحي وقتلة الشعب السوري، وهذا بدوره أثّر على تكرار السلوك من دون أدنى خوف لظهور مثل هذه الأدلة للعالم أو تقديمها للقضاء الدولي، لأنهم يعرفون أن لعبة توازنات السياسة قد تجعلهم في موقع المنتصر حتى وإن كان على حساب الضحايا.
وإلا فلماذا لم تؤثر شهادات الناجين والناجيات في الملف السوري وهم الأكثر دراية بالممارسات الوحشية وقد عايشوها؟ أو لماذا لم تسهم الصور والمشاهد الموغلة في العنف والدموية بتغيير فكرة الرأي العام العالمي عن الثورة السورية والاعتراف بها على أنها حق للسوريين في مواجهة الموت اليومي المتكرر، لماذا لم يسحب المجتمع الدولي الشرعية من نظام الأسد أو عمل على ردعه عن وحشيته على أقل تقدير؟؟
لم يعد السوري منا ينتظر إجابة لهذه الأسئلة فهو يعرف علم اليقين أن في جعبة المجتمع الدولي بمنظماته المدنية وتشكيلاته القضائية ما يمكن أن يدين النظام بالدليل القاطع ويجعله معزولاً دولياً ويعرضه لأقصى العقوبات، لكن وبما أن التجاذبات السياسية في المنطقة لم تحقق التوازن المرجو منها بعد، فإن الورقة السورية ما تزال قابلة للاستخدام ما يعني أن المحاسبة لا يمكن انتظارها على المدى القريب وقد تأخذ وقتاً أطول مما اعتقدناه أو حلمنا به.
لقد كانت صور قيصر فضيحة عالمية ثم مجزرة التضامن، استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة والحولة، مآسي مهجري الخيام، واكتشاف مقابر جماعية تدل على الهولوكوست السوري، لكنها لم تغير في مسار الملف السوري وأخذت حصتها من الإعلام ثم تلاشى أثرها مع الوقت، فهي لم تؤثر في الضمير العالمي شيئاً ولم تحدث انعطافة تاريخية في الملف السوري، ولم تنصف الثورة السورية في الوصف.
لقد كانت المجاهرة بالعنف هي الجريمة الأكثر وضوحاً لدى النظام السوري المستبد، ففي حين يحاول كل مجرم إخفاء أي أثر يدل عليه ويجعله عرضة للعقاب والحساب، كان النظام في دمشق لا يخشى في العنف لومة لائم ولا يهمه أن يُساق به إلى أروقة المحاكم الدولية أو إدانته بالإبادة الجماعية.
—————————-
=====================
تحديث 15 أيار 2022
——————————-
مقطع سوري .. الهوياتية في السياسة خيانة / راتب شعبو
حدثان هزّا الوجدان السوري أخيرا: الأول مجزرة يعود تاريخها إلى أبريل/ نيسان 2013، قتل فيها، بدم بارد، 288 مدنياً على يد عناصر تابعين للأمن العسكري، وصارت تسمّى في الإعلام “مجزرة التضامن”، لأنها وقعت في مخيم التضامن في دمشق، ويا لها من مفارقة أن تضاف هاتان الكلمتان إلى بعضهما. والثاني إشاعة عفو عن معتقلين بمناسبة عيد الفطر، جعلت الأهالي يهيمون على وجوههم وتطير بهم الإشاعات من مكان إلى آخر، وينامون في الطرقات منهكين خائبين، لتعود الغالبية الغالبة منهم خالية الوفاض، حتى من خبر عن أحبائهم المعتقلين. وكان حال مئات قليلة أفرج عنهم صادماً، فقد بدوا وكأنهم عائدون من موتٍ طويلٍ أنهك أشكالهم وصحتهم وعقولهم. وقد برع أحدهم في وصف هذا التجاور بين الحدثين بالقول “العفو عند المجزرة”. .. سوف تهتم السطور التالية في تأمل البيئة العدائية التي لا تفتر لدى أهل النظام في سورية، من أين تنبع، وكيف تتغذّى، وأين يتكثف حضورها.
كان يمكن دائماً لأي سوري، إذا حدّق في عين السلطة التي تحكمه، أن يشعر كم هو محتقر في هذه العين. وكان يمكن دائماً للسوري أن يرى في تلك العين تهديداً ثابتاً وعميقاً بلا قاع. وعلى كل حال، لم يتأخر هذا التهديد حتى أصبح واقعاً رهيباً. كان ذلك واضحاً في عين السلطة، حتى وهي مطمئنة وراضية وتضحك، فالثابت في هذه العين احتقار محكوميها، وعدم القدرة على النظر إليهم إلا بوصفهم محكومين أبديين لها، أي حقراء أبديين أمام جبروتها.
من الطبيعي أن يتولّد لدى السوري المكبّل بتلك النظرة، شعور غامض بالرعب، من ذلك النوع الذي ينتاب الكائنات، حين تكون أمام من يمتلك قدرة كاملة عليها، من دون أن يكون لديها القدرة على صدّه، ومن دون أن يكون لديه ما يردعه، فلا يبقى لدى الكائنات، والحال هذه، سوى الهروب بكل الأشكال الممكنة. وكان شكل هروب السوريين من السلطة التي استقرت وتمكنت، هو الاسترضاء. لا يمكن فهم مسيرات التأييد وأعياد الفرح والدبكات واستصغار الذات والتصويت بالدم وإسباغ صفات التعظيم والألقاب الكبرى على رأس السلطة، سوى بوصفها شكلاً من أشكال الهروب بالاسترضاء، لدرء الخطر وتفادي وقوع التهديد الرهيب الذي يطلّ على نحو ثابت من عين السلطة التي تدرك أن تحت أشكال التأييد توجد حقيقة الرفض.
هكذا استقرّت العلاقة عقودا، سلطة لا تشبع من احتقار محكوميها، ومحكومون تحكمهم غريزة الأمن والبقاء، فيبادلون المزيد من الاحتقار بمزيد من التعظيم، ويبتكرون صنوف الهرب والابتعاد عن الشر. تحطمت فجأة هذه العلاقة في مستهل ربيع 2011. أقصى ما يمكن أن يثير غريزة القتل لدى سلطة “أبدية” أن تواجه تحدّياً ممن تحتقرهم، أن يقف العبيد ويتحدّون السلطة التي كانوا يستصغرون أنفسهم أمامها. لا يمكن لسلطة الاحتقار أن ترتدّ على تحوّلٍ كهذا سوى بالدم، لا يمكن أن يشفي غليلها شيء سوى القتل. قد نعتقد أن هذا الارتداد الدموي ناجمٌ عن خوف السلطة من “إرادة الشعب”، وقد يكون لهذا الاعتقاد محلّ، ولكن الأكثر ثباتاً أنه ناجم عن الاحتقار، عن استفظاع حقيقة أن يقف في وجهها بشرٌ لم يظهروا لها سوى التعظيم والاسترضاء والاسترحام. أن يقف هؤلاء “الحقيرون” عند كرامتهم أمرٌ يثير لدى السلطة غريزة السحق. هذا الارتداد الدموي المباشر للسلطة يشبه الارتداد العنيف للفلاح ضد الكلب الذي حاول أن يعوي كالذئب، أو الدجاجة التي حاولت أن تصيح كالديك. في الحالتين، يبدو ما تقوم به هذه الكائنات تعدّياً على ناموس الكون، ويستوجب القصاص من “المعتدين”، لإعادة الانسجام إلى سابق عهده.
ويكون ارتداد السلطة أعنف كلما كان البشر الذين يتحدّونها أقلّ شأناً في نظرها. إذا كان يمكن لمثل هذه السلطة أن تتحمّل شيئاً من احتجاج نخبة اجتماعية، فإن تحدّي العامة لها يحرّض صميمها العنيف على نحو مباشر، فتستجيب بصنوف قصوى من العدوانية والعنف. ويبقى السؤال، أين يكمن مِحرَق هذه العدوانية؟ وكيف تتجسد؟ إذا كان مركز السلطة هو منبع العدوانية، فإن حضورها الكثيف يوجد في المحيط غير الرسمي الذي يمارس السلطة بأفظع أشكالها.
تجسّد التكثيف الأمثل لعدوانية سلطة الأسد في أبناء العائلة البعيدين عن السلطة الرسمية، والمتحرّرين بالتالي من أي قيد، وإن كان شكلياً، يمكن أن تفرضه المؤسّسة. شكّل هؤلاء واقعاً فريداً يمكن تسميته حيازة “السلطة المحض”، نقصد المستقلة عن أي وظيفة عامة تتطلبها السلطة عادة. ببساطة، كان هؤلاء أفراداً “عاديين” ولكنهم يمتلكون سلطة دولة. وهم إلى ذلك أفرادٌ سيئون في أخلاقهم وفي تصوراتهم، وهل يمكن لأفرادٍ هذا حالهم أن يكونوا سوى ذلك؟ وقد أفرزت هذه الظاهرة “الأسدية”، على مدى عقود حكمها، حوادث كثيرة لا معقولة في احتقار الناس، والتي يتذكّرها وسيتذكّرها طويلاً أبناء سورية، وأبناء اللاذقية بشكل خاص، بوصفها المحافظة التي نكبها القدر بهم.
حول أصحاب “السلطة المحض” هؤلاء، نشأ جيش من الأتباع والمستفيدين الذين يشكلون الذراع التنفيذية المباشرة، وهؤلاء هم من عُرفوا في سورية باسم “الشبيحة”. هؤلاء لا ينتمون إلى مؤسسة الدولة، ولكنهم أعلى سلطةً من جميع السلطات الرسمية لهذه المؤسسة. إنها في الواقع دولتهم رغم أنهم خارجها. والواقع أن تماهي هؤلاء بالدولة السورية، توازى، كتفاً بكتف، مع اغتراب السوريين عنها، وتحوّلهم إلى ضحايا على يد “دولتهم”.
الواقع أنه، في محيط كل مركز سلطة فعلية في الدولة الأسدية، نشأ امتدادٌ تشبيحي يحوز سلطة مستمدّة من سلطة المركز. والحقيقة التي يعرفها السوريون، أن السلطة التي يمارسها هذا الامتداد في الوسط العام تكون، في أحيان كثيرة، أعلى من سلطة المركز المباشر الذي تستند إليه، نظراً إلى ما للشبّيحة من صورة مخيفة في مخيلة السوريين، تجعلهم يتراجعون أمام كل من يبدو لهم أنه ينتمي إلى هذه الفئة.
امتلاك سلطة بلا قيود يدفع، بطبيعة الحال، إلى الاستهانة بالآخرين واحتقارهم. ومن هذه الأرضية، يمكن فهم العدوانية الرهيبة لهؤلاء في التعامل مع “الآخرين” أو مع “الحثالة” الذين تجرأوا على تحدّي السلطة. يزيد في العدوانية ويدفعها إلى حدود جنونية، النظر الضمني إلى المحتجين على أنهم طائفيون لا يحرّكهم مطالب وحقوق، بل كراهية طائفية ضد العلويين، وغالباً ما تجري تغطية هذه النظرة بتحليل “رسمي” لا يقلّ تحقيراً، يقول إن الاحتجاجات ليست سوى عمالة وخيانة لخارجٍ ما.
في النظرتين، المضمرة والمعلنة، هناك آلية إسقاط (projection)، الطائفي يرى الطائفية في خصمه، ومن خان عمومية الدولة وخصخصها بجعلها ملكية “أبدية” لعائلة، مستنداً أكثر فأكثر إلى الخارج، يرى العمالة والخيانة في خصمه.
في الصراع السياسي، البحث عن مصادر طاقة هوياتية (دينية أو إثنية) لتحقيق كسب سياسي هو مسعى يعادل الخيانة، لأنه طريقٌ مفتوحٌ إلى العنف الممعن في الفظاعات واللاعقلانية، وإلى مصادرة الصراع السياسي بوصفه كذلك، لصالح صراعات سيطرة وقتل وإبادة.
العربي الجديد
——————————
”شارع نسرين”.. الثقب الأسود جنوب دمشق/ عدنان علي
كان يحلو للبعض وصف حي التضامن جنوبي دمشق، بأنه بمثابة سوريا المصغرة، نظرا للتنوع السكاني والطائفي في الحي الذي استقطب منذ نشأته تدريجيا كامتداد لمخيم اليرموك سوريين من مختلف المحافظات إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين شكلوا تقريبا ربع سكان الحي. وتشكلت في التضامن تدريجيا حارات خاصة بأبناء كل منطقة بمن فيهم بشكل أساسي سكان بلدة “عين فيت” في محافظة القنيطرة بعد حرب 1967 والتي أدت إلى احتلال إسرائيل الجولان وجزء من القنيطرة.
ولم تعترف السلطات بالحي إلا في عام 1974، لكن دون أن يترافق ذلك بتقديم الخدمات الأساسية، أو تحسين البنية التحتية للمنطقة التي ظلت تعاني مشكلات حياتية عديدة، وتعتبر بشكل عام من مناطق السكن العشوائي جنوبي العاصمة دمشق.
ومع انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري في ربيع عام 2011، فرض النظام على تلك المناطق حصاراً تدريجياً، فيما تمترست القوات الموالية للنظام في نحو ثلث مساحة حي التضامن، مقابل سيطرة الفصائل المسلحة على نحو الثلثين مطلع العام 2012، وهو العام الذي شهد تبدلا في الواقع السكاني للحي، إذ نزح معظم سكانه إلى مدنهم وقراهم الأصلية بسبب اشتداد المعارك وقمع النظام وخشية الاعتقال والقتل، ومنهم كثر نزحوا أيضاً إلى مخيم اليرموك.
وفي المقابل وفد إلى الحي الموالون للنظام على أساس طائفي، وتمركزوا خاصة في شارع نسرين، وهم عبارة عن مقاتلي النظام وشبيحته وضباطه، ومعظمهم من متبني الفكر الطائفي أو من التابعين لإيران، وتركزت مهمتهم على قمع الاحتجاجات وقصف المناطق المتمردة ونصب الحواجز التي مثلت نقاط تصفية وإعدامات وخطف للمدنيين من أهالي التضامن والأحياء المجاورة.
وبدأ الحصار المفروض على مناطق جنوبي دمشق يتشدد حتى تحول إلى حصار كلي اعتباراً من النصف الثاني لعام 2013، وذلك بمشاركة ميليشيات ومجموعات مسلحة محلية (شبيحة)، أغلبها ذات طابع طائفي تولت قمع الاحتجاجات بعنف شديد، مع ارتكاب كل أشكال الانتهاكات والجرائم من اعتقالات وضرب وتعذيب وقتل وحرق واغتصاب.
وجرى كلّ ذلك بمنأى عن أي محاسبة من جانب قوات النظام، والتي كانت في الواقع تشارك تلك المجموعات هذه الجرائم وتشجعهم عليها، عبر عناصر منتدبين من أجهزة الأمن أو من جيش النظام، خصوصاً من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد، إضافة إلى ميليشيات فلسطينية تتبع لفصائل أحمد جبريل و”فتح الانتفاضة” و”فلسطين الحرة” ممن تولوا المواجهة مع فصائل المعارضة في المخيم، بينما تولت عصابات نسرين التنكيل بالمدنيين.
وأثار التحقيق الذي نشر أخيراً في صحيفة الغارديان البريطانية، وهو من إعداد الباحثة السورية أنصار شحّود والباحث التركي الكردي أور أوميت أونغر، العاملين في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام، صدمة في المجتمع السوري برغم تعوده خلال السنوات الماضية على أخبار المجازر والانتهاكات الفظيعة، لكنه الفيديو الأول الذي يوثق بالصوت والصورة مراحل إعدام عشرات المدنيين ورميهم في حفرة ومن ثم إحراقهم، مع ظهور وجوه القتلة بوضوح، والتعرف لاحقا على أسمائهم وصفاتهم.
كما اتضح أن هناك 27 فيديو آخر لدى الباحثين حول مجازر أخرى لم يتم الإفراج عنها حتى الآن.
شارع نسرين.. الثقب الأسود
تشكلت أهم المجموعات المسلحة التابعة للنظام في حي التضامن خلال الأشهر الأولى من انطلاق الثورة السورية، وهم من كانوا يعرفون بـ”شبيحة شارع نسرين”، وسرعان ما امتد نشاطهم إلى خارج منطقة التضامن وتشكلت منهم ميليشيا “الدفاع الوطني”، والذين كانوا يعملون إلى جانب فرع الأمن العسكري، لكن معظم أو جميع الجرائم المرتكبة تمّت بواسطة مجموعات “شارع نسرين”، وهم “خليط من المدنيين وعناصر الأمن أو الجيش، وغالبيتهم الساحقة من متبني الفكر الطائفي.
والشخصان اللذان ظهرا في الفيديو، هما أمجد يوسف، صف ضابط المتطوع في الفرع 227 التابع للأمن العسكري، من (عين فيت) ونجيب الحلبي مواليد 1984، وهومن سكان حي التضامن، وكان يدير قبل الثورة ملهى في منطقة باب شرقي، وبعد تصاعد الأحداث، جمع مجموعة من الشبيحة في حي التضامن، واتخذ مقراً له بجوار جامع عثمان في الحي، قبل مقتله عام 2015 خلال حفر أحد الأنفاق على جبهة التضامن.
وخلال المقابلات التي أجرتها معه الباحثة شحود عبر “فيسبوك” عبر يوسف عن فخره بارتكاب المجزرة ثأراً كما قال لمقتل شقيقه الأصغر 2013 خلال خدمته في قوات النظام.
وقال: “لقد انتقمت. لقد قتلت كثيراً، ولا أعرف عدد الأشخاص الذين قتلتهم”.
وإضافة إلى هذين الشخصين، كانت عصابة أبو منتجب الأكثر شراسة في قتل المدنيين. وأبو منتجب (صالح الراس) قائد إحدى المجموعات التابعة لفرع الأمن العسكري وهو ضابط مسرح لأسباب تمس النزاهة، ويعتبر من أعتى المجرمين خلال تلك الفترة، وارتبطت باسمه العديد من المجازر، من بينها المسؤولية عن اختفاء عائلة فلسطينية من آل العمايري بما فيها الأم وبناتها وابنها، كانت في زيارة عند ابنتها المتزوجة في التضامن وتم خطفهم جميعا.
وهناك شخص آخر يدعى حكمت الإبراهيم (أبو علي حكمت)، الذي كان مسؤولاً عن الشؤون العسكرية، وأشار إليه تحقيق الباحثين بصفته “قائد في الدفاع الوطني وعضو سابق في سرايا الدفاع، وكان يمتلك مقبرته البدائية لحرق جثث الضحايا الذين اعتقلهم عند الحواجز أو من مستشفى المجتهد”، إضافة إلى ياسر سليمان الذي يتحدر أيضاً من قرية عين فيت، وكان مستخدماً في المؤسسة الاستهلاكية، وعرف عنه بأنه كان يسرق السكر والرز قبل عام 2011، قبل أن يصبح بعد ذلك رجل أعمال وقائد مجموعة مسلحة.
وتضاف إلى هؤلاء، مجموعات الدفاع الوطني بدمشق بقيادة فادي صقر، ومجموعات تتبع للفرقة الرابعة وأمنها، وأيضاً مجموعات أبرمت تسوية مع النظام، وكبير كل هؤلاء اللواء بسام مرهج، قائد أركان الدفاع الوطني في سوريا.
مجازر بالجملة
بدأت عمليات التصفية من قبل هذه المجموعات في الأشهر الأولى من عمر الثورة وقبل ظهور السلاح في يد المعارضين. وتشير المعلومات المتقاطعة إلى أن عدد المفقودين كبير جداً، بعضهم تأكدت تصفيتهم، وكثيراً منهم لا أحد يعلم مصيرهم، بعد أن تحولت منطقة شارع نسرين إلى ثكنة عسكرية ضخمة وامتد نشاط المجموعات العاملة فيها، والتي يتم تسليحها من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام إلى مخيم اليرموك، حيث كانت تجري ملاحقة بعض الفارين من أهالي التضامن باتجاه المخيم.
وعلى غرار الضحايا في مجزرة التضامن والذين جرت تصفيتهم فوراً من دون محاكمة أو سؤال، فان معظم من تمت تصفيتهم خلال هذه الفترة هم من المدنيين، وقتلوا على قاعدة “التطهير الطائفي”، ذلك أن العسكريين، أي المنتسبين لـ”الجيش الحر” الذين كان يتم اعتقالهم لا يقتلون فوراً، بل كان يتم استجوابهم ببطء لأخذ معلومات منهم حول الفصيل الذي ينتمون إليه، ويتم تصفيتهم بشكل إفرادي، نظرا لقلة عددهم، وتباعد مواقيت احتجازهم.
ويشير أحد الناشطين إلى انه تمكن في عام 2014 من التسلل مع مجموعة رفاقه إلى هذه المناطق التي كانت تتم فيها التصفيات في حي التضامن، ووثق في إحدى الحالات وجود نحو 50 جثة لم تدفن، منها 15 جرى حرقها. كما عثروا ضمن “كتلة دعبول” على جثث كثيرة، وكذلك في منطقة سليخة.
كما ينقل ناشط فلسطيني من سكان حي التضامن، عن شخص التقاه في لبنان تعرض للاعتقال قوله إنه جرى اعتقاله في تلك الفترة عند فرن التضامن، وسيق مع آخرين، ليحبسوا كلّ 6 أو 7 أشخاص، في دكان، ويتم إغلاق الباب عليهم، ثم يجري إخراج رأس كل واحد من فتحة صغيرة في الدكان، وتخلع رقبته ليموت ببطء.
ويوضح أن المجموعة التي اعتقلته انشغلت بإعدام أشخاص آخرين، فتمكن من الهرب من الدكان، وانتقل زحفاً إلى شارع التضامن حتى وصل إلى مخيم اليرموك ثم هرب إلى لبنان.
هوية الضحايا
وتشير المعطيات إلى أن الكثير من الضحايا الذين جرت تصفيتهم في حي التضامن عام 2013 هم من اللاجئين الفلسطينيين ونازحي الجولان، إضافة إلى مدنيين من محافظات سورية عدة مثل درعا وإدلب ودير الزور، حيث كان القتل يتم بوضوح على أساس طائفي، أي الأفراد، بزعم أنهم يمثلون حاضنة شعبية للمسلحين الذين يقاتلون النظام، خاصة بعد أن جرى في تلك الفترة التي انتزعت فيها المعارضة المسلحة مناطق واسعة من يد النظام، وأطبقت على العاصمة دمشق، التهويل من جانب أتباع النظام بأنه إذا جرت الإطاحة بالحكم، فسوف ترتكب مجازر طائفية، ويجب منع حصول ذلك بأية وسيلة.
وحسب المعطيات، فإن الاعتقالات كانت تتم بشكل رئيسي على الحواجز الثلاثة على مداخل مخيمي اليرموك وفلسطين كونها الأقرب إلى حي التضامن، حيث ينقل المعتقلون إلى التضامن لتتم تصفيتهم هناك بعد ساعات قليلة، وذلك بعد أن رفع مسلحو “شارع نسرين” في تلك الفترة شعار “كل واحد بمية”، بحيث أنه كانوا كلما قتل أحدهم في الاشتباكات مع مسلحي المعارضة، أو خسروا نقطة عسكرية، يقومون بحملات اعتقال عشوائية في حي التضامن والأحياء المجاورة، خصوصاً مداخل حي اليرموك، وينقلون المعتقلين إلى حي التضامن، حيث تتم تصفيتهم على الفور، مع الإشارة إلى أن الحواجز على مداخل اليرموك، وخاصة حاجز البطيخة، كانت تشهد في تلك الفترة حركة نشطة لسكان اليرموك والحجر الأسود لتأمين احتياجاتهم الغذائية أو للخروج كلياً من المنطقة التي بدأ يشتد الحصار عليها بعد سيطرة فصائل المعارضة على المخيم نهاية 2012.
واليوم مع اتضاح بعض معالم تلك الجرائم المرتكبة في تلك البقعة الكئيبة، واتضاح هوية بعض المرتكبين والتي اشتملت على كل أشكال الفظائع التي نسيتها الطباع البشرية في القرن الحادي والعشرين، فان السؤال هو متى تتم محاسبة هؤلاء المجرمين الذين ما زال كثير منهم يحظون بحماية النظام، بل وبالتقدير العالي من جانب أنصاره، بوصفهم أبطال حموا الوطن من الإرهاب، وليسوا مجرد مجرمين سفلة، جميع ضحاياهم من المدنيين العزل الأبرياء.
والواقع ان المعارضة السياسية أهملت كثيرا في طرح هذه القضية أمام المحافل الدولية والحقوقية، ولم تشكل فرقا حقوقية مختصة بتوثيق جرائم النظام، وتحري سبل رفعها أمام الجهات الدولية المختصة السياسية والقانونية، وليس لدى الائتلاف المعارض مثلا فريق قانوني محترف للتعامل مع هذا الأمر، فيما يتركز نشاطه على إطلاق التصريحات العاطفية التي لا تسمن ولا تغني أمام مجتمع دولي غير مبال أصلا بالقضية السورية، أو على الأقل ليست من أولوياته، وثمة تقاطعات عدة تجمعه مع النظام القائم في دمشق.
——————————–
جورج صبرا: استثمار مجزرة التضامن قانونياً ضرورة لوضع القضية السورية على مسار الحلّ
أكد الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، جورج صبرا، على ضرورة استثمار التحقيق الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية يوم الخميس الماضي، لإدانة النظام السوري ووضع القضية السورية على مسار الحلّ.
وقال صبرا في حديث لـ”نداء بوست”: إنه بالرغم من أن جريمة حي التضامن تأتي في سياق المجازر المتعددة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام، ويتم اكتشافها أو الكشف عنها تباعاً، إلا أنها تحمل قدراً من الفظاعة والوحشية، وتشكل نتوءاً بارزاً في السجل الدموي الحافل لارتكابات النظام وفي سجل الجرائم العالمية الموصوفة، تُذكِّر بالهولوكوست النازي وجرائم الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف: “لأن العملية السياسية معطلة، أو وُضعت على رفّ القضايا المؤجلة، وما يجري تحت عنوان اللجنة الدستورية لا يمتّ إلى العملية السياسية بصلة، فهو خارج مسارها ومندرجاتها التي رسمتها القرارات الأممية ذات العلاقة”.
ويرى صبرا أن هذه المجزرة بتحقيقها الاحترافي وتوثيقها بالصوت والصورة خطفت جميع الأضواء، لأنها كشفت من جديد حقيقة النظام وحجم ارتكاباته المعروفة وما خفي منها، وأظهرت سر ممانعته للحل السياسي وإعاقته المستمرة لتقدُّم العملية السياسية بأي مقدار.
كما أن هذه المجزرة -يقول صبرا- “دفعت بالملف القانوني إلى الصدارة، لأنه مستمر بكشف طبيعة النظام الدموية والوحشية وحقيقة حماته وداعميه، وإثبات عدم رغبته بالحل السياسي وعدم أهليته لذلك”.
وأردف: “من احترف التنكيل وأعمال القتل والإجرام المتعدد الأشكال، وأوقع سورية وشعبها في هذه المحنة المستمرة غير مؤهل للعمل لإخراجنا من المحنة وبناء سورية الجديدة”.
ويعتقد صبرا أنه للاستفادة من كشف هذه الجريمة والاستنكار الذي أثارته ضد النظام، بما يشكل كشفاً وفضيحة وإدانة في الوقت نفسه، لا بُدّ من تثمير الحدث بإبراز الملف القانوني ووضعه كمحور للجهد الرئيسي في هذه المرحلة من خلال الأفراد والمنظمات السورية ذات العلاقة، لدفع المنظمات الدولية المعنية وراء مسؤولياتها.
وأضاف: “فكما أن جرائم النازية والفاشية فيما عرف بالهولوكوست استدعت العدالة الدولية للفعل عَبْر محكمة نورنبيرغ، فلا بُدّ من محكمة بل محاكم دولية تحاسب النظام ومجرميه، تقتص منهم وتنصف الضحايا”.
ويمكن أن تكون الجهود بهذا الاتجاه رافعة لإنزال القضية السورية عن رفّ التأجيل، لتوضع على مسار الحل، وتبقى مهمتنا كسوريين في المقام الأول للدفع وراء هذا المسار، لتحقيق العدالة والإنصاف ولو بعد حين، وفقاً لصبرا.
وقبل أيام نشرت صحيفة “الغارديان” تسجيلاً مصوراً يُظهر قيام ضابط من قوات النظام السوري يدعى أمجد يوسف، بتصفية عشرات المعتقلين في حي التضامن ورميهم في حفرة ومن ثَمّ سكب الوقود عليهم وحرقهم.
وأوضحت الصحيفة أن العنصر ينتمي إلى الفرع 227 التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية، ويعود تاريخ ارتكاب هذه الجريمة إلى نيسان/ إبريل عام 2013.
ويظهر الفيديو مجموعة من المدنيين معتقلين لدى قوات النظام، معصوبي الأعين، ومكبلي اليدين، ويسيرون نحو حفرة حيث يقوم عناصر النظام بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.
وقالت الصحيفة: “عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قَتَلَتُهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب”.
وفي تعليقه على هذا الفيديو، قال مارتن تشولوف، مراسل صحيفة “الغارديان” في الشرق الأوسط: “هذا أفظع ما رأيته في الصراع السوري بأكمله، هذه اللقطات تعطينا لمحة عن جزء لم يسبق وصفه من الحرب المستمرة منذ 10 سنوات”.
الجدير بالذكر أن الباحثيْنِ اللذين أعدا التحقيق أنصار شحود وأوغور أوميت أونجور، العامليْنِ في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام، تمكنا من الإيقاع بالضابط أمجد اليوسف وحصلا على اعتراف مصوَّر منه بجريمته.
نداء بوست
—————————-
==================
تحديث 17 أيار 2022
—————————-
واشنطن بوست: فيديو مجزرة التضامن ينكأ جراح أهالي المفقودين في سوريا
ترجمة: ربى خدام الجامع
على مدار سنين طويلة، تعلقت أسرة صيام بأمل لم شملهم بابنهم وسيم في يوم من الأيام، إذ يعتقدون أنه ما يزال محتجزاً في أحد سجون النظام وذلك بعدما فُقد عند مروره بحاجز للتفتيش قبل عقد من الزمان تقريباً.
إلا أن ذلك الأمل تبخر عندما رأوه في فيديو تم تسريبه حديثاً، فقد كان بين العشرات من السجناء الذين وقفوا معصوبي العينين، وقُيد كل منهم بالآخر، ثم سيق كل منهم، واحداً تلو الآخر، ليطلق عليه الرصاص ثم يرمى في خندق أعدته لهم قوات الأمن السوري.
“لا يمكن لأم أن تتقبل ذلك”
تعلق سهام صيام على ذلك الفيديو المرعب الذي صُور في عام 2013 ونشر أواخر الشهر الماضي بقولها: “لقد صدمنا حتى النخاع… فقد قتلوه بدم بارد… لا يمكن لأم أن تتقبل رؤية ابنها وهو يتعرض للأذى بهذا الشكل”، فكانت تلك تصريحاتها التي أدلت بها لوكالة أسوشيتد برس من مقر إقامتها في ألمانيا حيث تعيش مع أسرتها حالياً.
مجزرة التضامن
خلق هذا الفيديو موجة من الحزن والخوف الذي وصلت أصداؤه إلى أسر وعائلات الآلاف من السوريين الذين اختفوا خلال الحرب السورية التي امتدت لفترة طويلة. إذ بعدما نشر هذا الفيديو على الشابكة، هرع الآلاف ليدققوا بشكل مضن في هذا المقطع الذي نشر على الشابكة بحثاً عن آثار من اختفى من أقاربهم.
وحتى في الوقت الذي تحدث فيه جرائم وفظائع مشابهة في أوكرانيا، بقيت المجازر وحالات الاختفاء التي ارتكبت في الماضي خلال سني الحرب السورية بلا أي عقاب ولم يفتح بخصوصها أي تحقيق. ولهذا يتحدث أهالي المفقودين عن ذلك العذاب المضني الذي لا ينتهي والذي يعيشونه كل يوم دون أن يعرفوا أي شيء عن مصير أحبائهم.
فيديو مسرب مقابل حق اللجوء
تواردت أخبار حول قيام أحد رجال الميليشيات الموالية للنظام بتهريب هذا الفيديو من سوريا، حيث أعطاه هذا الرجل لباحثين في جامعة أمستردام، على أمل أن يساعده ذلك في الحصول على حق اللجوء في دولة بعيدة عن سوريا. وقد عمل هذان الباحثان على التأكد من صحة ما ورد في ذلك الفيديو، وتحديد موقعه والتعرف إلى هوية بعض الجناة الذين ظهروا فيه.
كانت صحيفة الغارديان البريطانية أول من نشر هذا الفيديو في أواخر شهر نيسان الماضي، وبعدها انتشرت النسخة الكاملة منه وتم تداولها بشكل واسع على الشابكة.
“الصندوق الأسود”
يعلق على ذلك محمد العبد الله وهو مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، فيقول: “حتى لو لم يظهر أحباء الأهالي في هذا الفيديو، لا بد لتلك الصور المريعة أن تنحفر في أذهانهم، وسيسأل كل منهم نفسه إن كان أقاربه قد لاقوا المصير ذاته أم لا”.
كما وصف العبد الله السجون السورية بالصندوق الأسود، وذلك لأن من يحتجز أو يقتل فيها تنقطع أخباره ولا يعلم أحد عنه أي شيء.
بيد أن معرفة الحقيقة تجلب معها نوعاً آخر من العذاب، إذ أصبحت سهام وزوجها يشاهدان هذا الفيديو كل يوم، ليتابعا آخر لحظات ابنهما وهو ما يزال على قيد الحياة وليودعاه قبل موته.
ظهر على الفيديو التاريخ التالي: 16 نيسان، 2013، أي بعد مرور يومين على اختفاء وسيم، وهو أب لطفلين، لو عاش لبلغ اليوم التاسعة والثلاثين من عمره، لكنه اختفى عند حاجز للتفتيش بالقرب من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين القريب من دمشق.
المجزرة
يظهر في ذلك الفيديو ومدته 6 دقائق و43 ثانية عناصر من الفرع 227 سيئ الصيت وهو يتبع للمخابرات العسكرية في سوريا، مع رتل مؤلف من قرابة 40 سجيناً يقفون في مبنى مهجور بمنطقة التضامن، وهي ضاحية قريبة من مخيم اليرموك تقع على تخوم دمشق. وطوال ردح طويل من الحرب، تحولت تلك المنطقة لخط جبهة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة.
المجرم أمجد يوسف وهو يغتال الضحايا في مجزرة التضامن – المصدر: غارديان
يظهر السجناء في ذلك الفيديو معصوبي العينين، وقد قيدت أيديهم خلف ظهورهم، ثم يقوم عناصر مسلحون من الفرع 227 باقتيادهم واحداً تلو الآخر ليصلوا إلى حافة خندق مملوء بإطارات سيارات قديمة، وهناك يدفعونهم نحو الحفرة أو يركلونهم وهم يطلقون النار عليهم في أثناء سقوطهم.
خلال تلك اللعبة الوحشية، يخاطب العناصر بعض السجناء، وبينهم وسيم، ويخبرونهم بأن عليهم اجتياز زقاق فيه قناص، لذا عليهم أن يركضوا بسرعة، غير أن السجناء يتعثرون بجثث من سبقوهم، وبعدما تكومت تلك الجثث بعضها فوق بعض في تلك الحفرة، من دون أن تفارق الأرواح أجساد بعضهم التي بقيت تتحرك، أخذ المسلحون يطلقون النار على تلك الكومة.
ثم أضرم المسلحون النار بالجثث، ويفترض أنهم قاموا بذلك لطمس كل معالم المجزرة وآثارها.
أعداد المفقودين في سوريا
ما يزال 102207 أشخاص مفقودين منذ أكثر من 11 عاما أي عند بداية النزاع في سوريا، وذلك بحسب ما أوردته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقد ذكرت تلك المنظمة أن المسؤول الأول عن تلك الاختفاءات القسرية هو النظام السوري الذي أخفى 86792 شخصاً، بالإضافة لوجود عدد غير معلوم ممن اختفوا في متاهة السجون السرية، ويأتي تنظيم الدولة في المرتبة الثانية بما أنه مسؤول عن 8648 حالة من حالات الإخفاء القسري، وفي المرتبة الثالثة تأتي فصائل المعارضة المسلحة التي أخفت 2567 شخصاً، أما البقية فمحتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة أميركياً أو لدى مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة.
أهل وجيران
ذكر أحد من تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس أن 25 شخصاً من أقاربه أخذهم عناصر تابعون للفرع 227 من بيوتهم في التضامن خلال شهر تموز 2013، ويضيف هذا الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه ما يلي: “إننا متأكدون من أنهم قتلوا بالطريقة ذاتها (أي تلك التي ظهرت في الفيديو)، لأن من أخذهم هم الأشخاص ذاتهم الذين ظهروا في الفيديو”، وأعلن هذا الرجل أن الأهالي يعرفون بوجود العديد من الحفر في منطقة التضامن والتي أحرقت فيها جثث من قتلوا هناك. أما عناصر الأمن الذين ظهروا في الفيديو فقد كانوا جيراناً لأهالي المفقودين وكانوا يعرفون بعضهم بعضا منذ أكثر من ثلاثين سنة حسب قوله.
مجزرة التضامن ومحاسبة الأسد
ومن بين أقاربه المفقودين هنالك أطفال وشقيقته التي ذهبت لتتفقد ما حل بأسرتها بعد مرور يومين على اقتياد أفراد تلك الأسرة من البيت، لكنها لم تعد منذ ذلك الحين.
إلا أن مأساة عائلته لا تنتهي عند هذا الحد، إذ بعد مرور بضعة أشهر على ذلك، اعتقل شقيق له على حاجز للتفتيش بما أنه لم يكن موجوداً في البيت عندما اختفت أسرته، وبعد مرور سنوات على ذلك، ظهرت صورة لجثته التي تعرضت لتعذيب شديد ضمن ملف ضم عدداً كبيراً من الصور والوثائق التي هربها أحد المنشقين المعروف باسم قيصر.
في رسالة مفتوحة طالبت 17 منظمة حقوقية ومدنية في 9 أيار الجاري مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق حول عمليات القتل تلك ومحاسبة مرتكبي تلك المجزرة ومن أعطوهم الأوامر، كما استنكرت تلك المنظمات عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء تجاه سوريا، وأعربت أنه سمح للأسد وحلفائه بمواصلة ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري مع إفلاتهم من العقاب.
الأهالي وعذاب السنين
يصف أهالي المغيبين في سوريا سنوات العذاب والبحث من دون أي جدوى وما تخللها من بصيص أمل زائف، إذ يخبرنا ماهر الذي يتمنى أن يكون شقيقه المفقود منذ عام 2013 ما يزال حياً وأن يطلق سراحه يوماً ما، أن الأمر يصبح أشبه بضربة جديدة مع كل مرة يتم فيها الإعلان عن إخلاء سبيل عدد من السجناء ويكتشف أن شقيقه ليس بينهم، ويتابع هذا الرجل الذي طلب عدم الكشف عن كنيته بالقول: “يحاول المرء أن يتكيف بمرور السنين، إلا أن الجرح ينكأ مع كل تقرير يخرج للعلن”.
“صناديق الموت”
اختفى شقيق ماهر في أثناء محاولته جلب مساعدات غذائية تقدمها وكالة الأونروا الأممية التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويخبرنا ماهر أنه تم اعتقال المئات من الأشخاص عند ذهابهم للحصول على صندوق المساعدات الغذائية، ولهذا أصبح الكثيرون يطلقون على تلك الصناديق اسم صناديق الموت.
وحتى يتجنب الناس الاعتقال، صاروا يرسلون أكبرهم سناً ليأتي بها حسبما أورد ماهر، فقد ذهب شقيقه أربع مرات للحصول على ذلك الصندوق، وفي المرة الخامسة تم اعتقاله.
وفي حال تأكد نبأ وفاته، “سيصبح الجرح مفتوحاً على اتساعه، ثم ستبدأ المعاناة الحقيقية بعد ذلك” برأي ماهر.
تجار الحرب
ثمة حفنة من المتربحين من هذه الحرب تقتات على دم تلك العائلات والأسر، حيث تبتزهم للحصول على مبالغ طائلة من الأموال مقابل وعود كاذبة بالإفراج عن أقربائهم بشكل نهائي.
بعد أيام على خروج هذا الفيديو الذي تظهر فيه عمليات القتل تلك إلى العلن، أصدر بشار الأسد عفواً على المئات من السجناء، ما دفع الأهالي للتجمع في إحدى ساحات دمشق، وهم يحملون صور المفقودين من أقاربهم، ويتوسلون إلى المخلى سبيلهم للإدلاء بأي معلومة عنهم، وذلك بحسب ما ظهر في الفيديوهات التي بثتها قنوات إعلامية تابعة للنظام.
وفي خضم كل ذلك، انتشر المتربحون من هذه العملية، فصاروا يخبرون الأهالي أن بوسعهم أن يدرجوا أسماء أقاربهم وأحبائهم ضمن قوائم المخلى سبيلهم مقابل مبلغ 50 مليون ليرة سورية، ما يعادل 13 ألف دولار أميركي، بحسب ما أورده العبد الله، الذي علق على ذلك بقوله: “كلها أكاذيب”، ومع ذلك ماتزال بعض العائلات تدفع لهؤلاء على أمل الحصول على أية معلومة.
من برلين، ذكرت وفاء مصطفى لوكالة أسوشيتد برس: “كيف أرفض عندما تكون حياة أبي معلقة؟ كيف أرفض حتى لو كنت أعرف أنهم يكذبون؟”
إذ تملأ صور أبيها المفقود منذ أن اقتيد من بيته في عام 2013 جدران غرفتها، ولهذا تتابع بالقول: “إنه لمن الجنون أن يبقى النظام مسيطراً علينا وعلى عقولنا وأجسادنا بعد مرور 11 عاما، وبعدما تركنا البلد،… أي إنه يتحكم بكياننا ووجودنا بالكامل”.
المصدر: واشنطن بوست
تلفزيون سوريا
——————————
الطائفية على إيقاع مجزرة التضامن/ حسام جزماتي
يوم الخميس الماضي نظمت «جامعة الشمال الخاصة» ندوة ومعرض صور عن مجزرة حي التضامن المتفاعلة باطراد، تحت عنوان «حفرة التضامن شاهد جديد على إجرام 50 عاماً».
جامعة الشمال، في مدينة سرمدا الحدودية، هي ثاني أكبر جامعة في محافظة إدلب بعد جامعتها «الرسمية» التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة الإنقاذ. وقد اجتذبت العديد من الطلاب والطالبات بسبب وجود كلية للصيدلة فيها، وكلية للهندسة المعلوماتية، فضلاً عن كليات أخرى أصغر، ومعاهد للتخدير والتحاليل الطبية والصيدلة والتعويضات السنّية وغيرها.
أقيمت الندوة في مدرج «الثورة» في مقر الجامعة. وتلي فيها عدد من الكلمات التي كان أشدها، ربما، ما جاء عن موضوع «تاريخ النصيرية في الحكم في سوريا» في كلمة ألقاها أستاذ محاضر في كلية العلوم السياسية بالجامعة نفسها، حائز على الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة دمشق، يدرّس أساساً في قسم التاريخ بجامعة إدلب.
في كلمته يقدّم الدكتور شطرنجاً من المعلومات الصحيحة والخاطئة بالتناوب، أو يعمّم المعلومة الصحيحة جزئياً فتصبح خاطئة. ليخلص، بنتيجة ذلك، إلى خطاب طائفي تحريضي. فمن المعلومات الخاطئة اعتباره «جيش الشرق» الذي أسسته قوات الانتداب الفرنسي «جيشاً علوياً خالصاً»، رغم أنه مكون من غالبية من أبناء الأقليات المحلية المتنوعة، ومنهم العلويون، ومن جنود من مستعمرات بعيدة. وكذلك اعتباره «اللجنة العسكرية» التي أسسها ضباط بعثيون أيام الوحدة السورية المصرية «محفلاً ماسونياً» أنشأته الطائفة العلوية في سياق تكتلها، رغم أن اللجنة كانت مكونة من أبناء أقليات عديدة، وقد اصطدم أعضاؤها العلويون في أثناء صراعهم الخاص، فقضى رئيسها محمد عمران اغتيالاً بأمر من حافظ الأسد، وأمضى صلاح جديد، رجلها القوي، بقية عمره في سجن المزة.
وفي جوابه عن السؤال الذي طرحه «لماذا يرتكبون هذه المجازر بحقنا؟» يقول الدكتور إن «هذا نابع من عقيدة هذه الطائفة المتوحشة… التي لم تدخل الحضارة». فيجب اقتلاعنا، نحن السنة، من الأرض لإرضاء إلههم الذي يشبه إله اليهود يهوه. بل إنهم «القبيلة اليهودية الثالثة عشرة المفقودة» كما يذكّر المحاضر أنه قال أكثر من مرة.
ما الحل إذاً؟ واضح أن السياق يقود إلى سبيل وحيدة، دموية وصفرية، إما نحن وإما هم. دون أن ينسى أستاذ التاريخ الحديث والعلوم السياسية أن ينبهنا إلى أن ذلك لن يتم دون اقتلاع المنظومة الدولية القائمة، بما أنهم عملاء لها وحلفاء، من روسيا إلى أميركا وإسرائيل.
كان يمكن تجاهل هذا الخطاب لولا امتلاء المدرج بالشبان والشابات الذين ربما تلقوا ما قاله أستاذهم على أنه حقائق ثابتة وخلاصات، وهو يورد في أثناء كلامه استشهادات موجهة من كتب ميشيل سورا وباتريك سيل ومحمد كرد علي. وأيضاً كان يمكن التغاضي عن ذلك كله لولا أن هذا الخطاب صار شديد الرواج والجاذبية بعد أكثر من عقد من التوحش، ولولا استنفاره في مناسبات مستفزة للمشاعر والغرائز مثل مجزرة التضامن.
فمنذ انتشار الفيديو المسرّب وسماع اللهجة العلوية للمرتكب الرئيسي لها، وهو ما أكده الكشف عن اسمه ومنبته، التهبت خطابات الاستئصال. وكما فعل الأستاذ الجامعي يفعل كثيرون أقل علماً، فيرفعون الملمح الطائفي للنزاع من درجة أنه أحد أبرز سماته إلى كونه تعريفه الوحيد. يُغفلون السياسة والاقتصاد والاجتماع والنفوذ لصالح تأبيده كصراع هويتين لا حل له إلا بمحو إحداهما للأخرى، كلياً أو تقريباً. في خطاب يفتقر إلى أبسط مقومات العدالة، إذ يُجمل المجرمين من العلويين مع آخرين منهم لم يشاركوا في المجزرة الكبرى، سواء لرفضهم لها أو لظروف خاصة كالعمر والجنس وعوامل شتى. ومن البديهي أن أي محاكمة نزيهة ينبغي ألا تطول هؤلاء الأخيرين وإن صفقوا للطائرات وتغنوا بالبراميل ورقصوا للكيماوي وشكلوا حاضنة تساند المجرمين. فكل هذا يدخل في إطار الكلام، الوحشي والداعم للقتل بلا شك، ولكن لا شريعة ولا قانون يساويان بينه وبين الفعل في العقوبة المطلوبة. فضلاً عن أن الدعوات إلى الإبادة هي ما عزز تكتل الطائفة المشدودة ذعراً في الأصل، وحال بين الثوار، مع أسباب أخرى، وبين الحصول على أسلحة نوعية. ورغم مرور عقد على استعصاء هاتين المسألتين فإن عواملهما الأساسية ما زالت كما هي، وليس بين حلولهما خطاب الاقتلاع.
في كل مناسبة كهذه يرفض الغاضبون أي محاولة للتعقل، وإن كانت مبنية على مقتضيات العدالة والمنطق، بدعوى افتقار العالم إلى أي منهما بعدما عجز عن وقف المقتلة الكبرى التي طالت أغلبية من الطائفة السنّية كما هو واضح. ويسخرون من أي محاولة لتهدئة الحقد بوصفها قائمة على خطاب «وطني» نظري، يسميه بعضهم «وتنياً» في اتهام لحامليه بالنعومة والتغريب الفكري والمزاج «الكيوت» والبعد عن «الأرض»، أو «وثنياً» لمخالفته الشريعة كما يراها بعض آخر. والحال أن مطلب العدالة ليس وطنياً بالضرورة، والمفترض أنه جزء مكين من خطاب الثوار الآذاريين وعتاة الإسلاميين على السواء.
لكن ما يحرض الخطاب الاستئصالي هو التعرض الطويل لوحشية النظام دون رادع، في السجون وبالقصف المنفلت وفي أثناء حصارات الجوع أو الركوع. ولا يمكن بناء أمل جدي في تراجعه طالما تسود بيئة الضحايا مشاعر العجز والمرارة والمظلومية التي عبّر عنها شعار الندوة: «آلاف المجازر وما زال المجرم طليقاً».
المحاسبة أولاً، والعدالة آخراً ودوماً.
تلفزيون سوريا
—————————-
الإبادة الأسدية والفهم المستعار/ حسن النيفي
لقد أخفقت قوى الثورة والمعارضة في سورية – سياسياً وإعلامياً – على مدى أحد عشر عاماً في إظهار الفحوى الجوهري لقضية السوريين، كما أخفقت في جعل القضية السورية تحظى بدرجة من الأولوية على أجندات المجتمع الدولي، ولا يعود هذا الإخفاق إلى ندرة في المُنجَز الثوري السوري، ولا إلى شحّ في التضحيات، وليس كذلك إلى وعيٍ مجتمعي متخلف كما يزعم آخرون، بل غالباً ما يأتي الإخفاق من أحد جانبين، أو كليهما معاً، فإمّا أن يكون من جعل نفسه وصيّاً أو وكيلاً عن القضية كان جاهلاً – بالأصل – بماهيّة تلك القضية وأبعادها الحقيقية، أو أنه يعرف ماهيتها ولكنه يجهل السبل والوسائل السليمة التي تمكّنه من الدفاع عنها بنجاح، ولكن في كلتا الحالتين النتيجة واحدة، إذ إن الضحية هم أصحاب القضية دائماً، وليس الوكلاء.
لعل ما يسوّغ لنا الإقرار بهذه الحقيقة الموجعة هو المفارقة التي أحدثها الفيديو الذي نشرته صحيفة الغارديان أواخر نيسان الماضي، والذي يبيّن وقائع المجزرة التي ارتكبها نظام الإبادة الأسدي في حي التضامن بدمشق في شهر نيسان من العام 2013 ، ولعل هذه المفارقة لا تنطوي على مزيد من التعقيد، إذ تؤكد ببساطة: إن صوت الضحية كان أكثر مصداقيةً وبلاغة من صوت السياسي، ذلك أن صوت الضحية يستند إلى قوّة الحق، بينما صوت السياسي استند إلى قوة السياسة التي افتقد الساسة السوريون أكثر مقوّماتها، فضلاً عن أن نجاح السياسة مرهون بما يملكه السياسي من أوراق قوّة على الأرض، واليوم لعل السوريين قد فقدوا معظم أوراقهم، إن لم نقل لقد جعلوها رهينة بيد الآخرين. وبطبيعة الحال لا يمكن التنكّر لمجمل العوامل التي جعلت من فيديو مجزرة التضامن يحظى بهذا التأثير والانتشار، ولعل في طليعة تلك العوامل هو الموقف البريطاني الحازم من الحرب الروسية على أوكرانيا، علماً أن الأوربيين جميعاً، بل العالم أجمع، يدرك أن الداعم الأكبر لجرائم الطغمة الأسدية هم الروس، وحين يتحدث العالم – اليوم – عن جرائم بوتين في أوكرانيا لا بدّ ان يكون الحديث مقروناً بجرائمه في سورية، وهكذا بات فضح جرائم الأسد في سورية يأتي في سياق تسليط الضوء على الإجرام الروسي وملحقاته في جميع أنحاء العالم. ولكن السؤال الذي يبقى يردده الكثيرون بعفوية : لماذا التركيز على مجزرة التضامن فقط؟ علماً أن ثمة مجازر أسدية أخرى لا تقل فظاعة عن مجزرة التضامن، إن لم تكن أشدّ منها فظاعة بكثير، فما قامت به الميليشيات الإيرانية في ريف حلب الجنوبي هو أشدّ إيلاماً ووحشيةً، إذ إن إلقاء المواطنين في الآبار، وقيام الجرافات بردم التراب والحجارة فوقهم وهم أحياء، لهي ميتةٌ أشدّ وحشية من إطلاق الرصاص، وكذلك اقتحام الشبيحة الطائفيين لقرى بانياس، وتحديداً لقرية البيضا، وذبح الأطفال والشيوخ بالسكاكين لهو أشدّ ترويعاً مما حصل في مجزرة التضامن، بل هناك العشرات وربما المئات من المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد بحق السوريين، وكل واحدة منها تحمل أبلغ الدلالات عن طبيعة الإجرام الأسدي ودمويته، وعلى الرغم من كل ذلك، لم تكن هذه المجازر موضع اهتمام المعارضة الرسمية السورية، بينما فيديو مجزرة التضامن كان نتاج جهد توثيقي إستثنائي قام به ناشطون من خارج فضاء الكيانات الرسمية للمعارضة، وبالطبع لا يمكن تفسير سلوك المعارضة الرسمية بعدم الاكتراث بالجانب الحقوقي والإنساني واعتماده منطلقاً للدفاع عن القضية السورية، على أنه نقص معرفي أو ندرة في المعلومات أو الافتقار إلى التوثيق فحسب، بل لعل الأهم من ذلك كله هو المفهوم الخاطئ الذي يتحكّم بتفكير تلك المعارضة في مواجهتها لنظام الأسد، ذلك أن الذين تدافعوا إلى كيانات المعارضة ذات التأسيس المستعار من الخارج، كذلك سارعوا إلى تبنّي فهمٍ ( مُستعار) أيضاً فيما يخص ماهيّة نظام الأسد، ولم يعتمدوا على فهم نابع من معرفة السوريين ومعايشتهم ومعاناتهم في ظل نظام الأسد طيلة نصف قرن،فحين وصف المجتمع الدولي حكم آل الأسد بأنه نظام إستبدادي لا ديمقراطي قمعي متفرّد بالسلطة، وبناء على ذلك، لا بدّ من إيجاد السبل المؤدية إلى إصلاح نظام الحكم وتحويله إلى نظام ديمقراطي يتأسس على سيادة القانون ومبدأ تداول السلطة، وانطلاقاً من هذا التشخيص جاءت القرارات الأممية ( جنيف1 – 2118 – 2254 ) لتؤكّد جميعها على ضرورة إنشاء هيئة حكم إنتقالي تتشارك فيها السلطة والمعارضة، ثم كتابة دستور جديد، ثم انتخابات بإشراف أممي، ولعله من الطبيعي أن تأتي وصفة العلاج الأممية منسجمةً مع التشخيص المنقوص أو القاصر لماهيّة المشكلة، ولكن المؤسف والمؤلم معاً أن المعارضة ذهبت إلى ما دون تلك الوصفة المنقوصة أو المشوّهة، فتخلّت عن فكرة ( هيئة الحكم الإنتقالي) وذهبت إلى مسار أستانا الذي أفضى بدوره إلى سوتشي، ثم مسار اللجنة الدستورية العبثي.
لعل اختزال المشكلة الأسدية بفكرة ( الاستبداد السياسي)، و من ثم القناعة بجدوى إصلاح النظام سياسياً ودستورياً، هو ما جعل المعارضة أكثر تماهياً مع الفهم ( المُستعار) لأصل المشكلة، وبالتالي أكثر تماهياً – أيضاً – مع المسارات التفاوضية التي باتت تنزاح شيئاً فشيئاً عن أيدي السوريين، بل ربما باتت بالمطلق بأيدي أطراف خارجية، إقليمية ودولية، ولم يبق للسوريين إلّا الدور الوظيفي الذي يحدّده ويرسم معالمه الآخر الخارجي. في حين أن ما يؤكده فيديو مجزرة التضامن، وكذلك المجازر الأخرى، وبنصاعة لا تقبل أي لبس، أن جذر المشكلة السورية لا يتجسّد بنظام حكم إستبدادي يمكن للديمقراطية أن تتسلل إلى أركانه عبر الإصلاح، ولا يتجسّد أيضاً بوجود حاكم يعشق السلطة فقط، ويسعى للبقاء في الحكم تلبيةً لنزوعه السلطوي فحسب، بل يمكن التأكيد على أن ما تؤكّده مجازر آل الأسد بحق الشعب السوري هو أن السوريين ليسوا في مواجهة نظام مستبد سياسياً بل في مواجهة نظام إبادة توحّشي إستئصالي، وليسوا كذلك في مواجهة حاكم يريد الاستمرار في حكم البلاد، بل في مواجهة طغمة لا ترى في سورية سوى عقار أو مزرعة تملكها هي، وجميع من في المزرعة من مخلوقات ليسوا سوى قطيع يدين بوجوده إلى مالكه، بل ربما كانت دموية الأسد أو توحّشه نابعاً في الأصل من اعتقاده بأنه يدافع عن ملك عضود يخصه وحده و لا حق للسوريين فيه، وبناء على هذا التصوّر فلا يمكن أن تكون معركة آل الأسد مع السوريين سوى معركة وجودية، معركة مصير، فسورية لا تحتمل وجود نقيضين ( آل الأسد – الشعب ) بل لا بدّ من استئصال أحدهما.
جانب كبير من معضلة المعارضة الرسمية السورية تكمن في توهّمها بأن ( الإبادة الأسدية) ذات منشأ يعود تاريخه إلى آذار 2011 ، في حين تشير الحقائق إلى أن علائم الإبادة كانت جزءًا من بنية الطغمة الأسدية منذ اعتصابها للسلطة عام 1970 ، فالنسخة الأولى من مجزرة حي التضامن قد حصلت في نهاية سبعينيات القرن الماضي في حي المشارقة بحلب، ثم تتالت النسخ الأكثر إبادةً في سجن تدمر (حزيران1980 )، ثم في حماة ( شباط 1982 )، فما الذي يجعل أشكال الإبادة قبل 2011 يختلف عما بعدها؟ أليس القاتل واحداً ومنهج الإجرام واحداً؟ أليس الضحايا في كلتا الحقبتين هم من السوريين أنفسهم؟
على امتداد نصف قرن، لم تتوان الطغمة الأسدية في التعبير عن ماهيتها بأبلغ الوسائل وأشدّها وضوحاً، وفيديو مجزرة التضامن لم يكن أكثرها بلاغةً، ولعل هذه الحقيقة لم تعد خافية على معظم السوريين، بل ربما كانت الباعث الحقيقي لانطلاق ثورتهم ( سورية لينا وما هي لبيت الأسد)، باستثناء من قفز وادّعى قيادتهم، فاستمرأ الوهم، ثم اتخذه وسيلة للاعتياش.
————————–
تحرك لمعاقبة كبار المسؤولين السوريين.. هل «تقصم» مجزرة حي التضامن «ظهر» الأسد؟!
من المؤكد، أن النظام السوري قد إقترف آلاف الجرائم الموثّقة بحق الشعب السوري منذ إندلاع الحرب في سوريا في العام 2011 إلى جانب حلفائه، الذين مارسوا شتّى أنواع الممارسات الوحشيّة، بحق مدنيين عُزّل في العديد من الأحياء والمُدن السورية، التي فرضوا سيطرتهم عليها بقوّة القهر والتعذيب والترهيب، والمُقايضة بين الخروج من المُدن أحياء، أو الموت تحت أنقاض منازلهم كما كان حصل في مدينة “مضايا” في الزبداني. وإستعاد العالم بأسره مشاهد تقشعّر لها الأبدان من خلال المجزرة المروعة الأخيرة، كان ارتكبها عناصر من النظام السوري من الفرع 227 في المُخابرات العسكرية في حيّ الميدان في دمشق في العام 2013، والتي راح ضحيّتها نحو أربعين مدنياً قضوا جميعهم رمياً بالرصاص داخل حفرة موسّعة، أقامتها مجموعة العناصر نفسها والتي استُخدمت كمقبرة جماعية يومها، في مُحاولة من النظام السوري لإخفاء معالم الجريمة. اقرا ايضا: وعود نصرالله «الإنتخابية _النفطية» «تتبخر» بعد 15 أيار! في السياق، تؤكد مصادر حقوقية سوريّة مُعارضة ل”جنوبية”، أنه كان يُمكن لهذه الجريمة التي كُشف النقاب عن مُرتكبيها بالصوت والصورة، أن تمرّ كما مرّ غيرها من الجرائم التي وقعت خلال الحرب السوريّة، والتي تقاذف فيها النظام والفصائل المُسلحة المسؤولية حولها، قبل أن تُطمر الحقائق بين مفاوضات من هنا وفيتوات من هناك، لولا أن هناك مساع دولية ومحليّة سوريّة هذه المرّة، لمُحاسبة فعليّة تقودها المنظمّات الحقوقية بحق مسؤولين عسكريين وأمنيين كبار، داخل النظام السوري من بينهم من هم في مواقع قيادية اليوم”. وتلفت المصادر أن “هناك مسارات كان يجب أن تسلكها الدول الفاعلة والمؤثرة في المنطقة، تقوم اليوم على التخلّص من بعض الوجوه والشخصيّات داخل النظام لسببيين: الأوّل وجود بصمات واضحة لها، في العديد من المجازر التي إرتُكبت على مدار سنوات الحرب في سوريا، والسبب الثاني أن المرحلة المُقبلة في سوريا تتطلّب من رئيس النظام السوري بشّار الأسد ومن حوله، تقديم “قرابين” للمحاكم الدولية ضمن عملية تطهير مبدئية لعدد من أركان رموزه”. مصادر حقوقية سورية: هناك مسارات كان يجب أن تسلكها الدول الفاعلة والمؤثرة في المنطقة تقوم اليوم على التخلّص من بعض الوجوه والشخصيّات داخل النظام وتُؤكد المصادر أن “الفترة المُقبلة ستشهد تهاوي العديد من الرموز في بنية النظام، من خلال إستدعاءات دولية لمُحاكمتهم، وذلك كخطوة أساسية مُتفقّ عليها دولياً للمباشرة في إعادة إعمار سوريا يقودها الأسد بجناحين مكسورين، في ظُل مُحاصصة دولية بحيث يُصار في الفترة ذاتها، العمل على إنتقال سلس للسلطة، أيضاً بطريقة تحفظ مصالح الدول المؤثّرة وبإتفاق مع الأسد نفسه”. هناك منظّمات سورية ودولية طُلب منها تحضير ملفّات تتعلّق بجرائم عديدة موثّقة أُرتُكبت في مناطق ومُدن كانت تقع تحت سيطرة النظام وحلفائه وتكشف المصادر نفسها، أن “هناك منظّمات سورية ودولية، طُلب منها تحضير ملفّات تتعلّق بجرائم عديدة موثّقة، أُرتُكبت في مناطق ومُدن كانت تقع تحت سيطرة النظام وحلفائه، وستقوم هذه المنظّمات بمد رئيسة مجلس الأمن للدورة الحالية المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، بجميع الوثائق والأدلة التي تُدين النظام على رأسها مجزرة حي التضامن”
————————–
==================
تحديث 22 أيار 2022
———————-
مرسوم العفو بعد مجزرة “التضامن”.. أي رسائل أرادها النظام السوري؟
مركز حرمون للدراسات المعاصرة
قُبَيل عيد الفطر بأيام، شهدت سورية حدثين مؤلمين، هزّا الضمير السوري والإنساني، وأعادا إلى ذاكرة الشعب السوري سيرة الثورة، وخصوصًا في سنيها الأولى، ومجازر النظام المروعة والمتتابعة بحق السوريين الذين ثاروا على النظام طلبًا للحرية والكرامة. أوّل هذين الحدثين مقطع فيديو نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، يصوّر إحدى المجازر التي ارتكبتها قوات النظام في منطقة “التضامن” بدمشق؛ وثانيهما مرسوم “عفو رئاسي” قضى بالإفراج عن معتقلين، وفقًا لقانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012، ليعاني معهما السوريون آلام الفجيعة بأبرياء قُتلوا خارج القانون بدم بارد، وآلام مشاهد الأهالي الملتاعين الباحثين عن أبنائهم الذين غُيّبوا لأكثر من عقد من الزمن، في غياهب السجون والأفرع الأمنية، فضلًا عن الحالة المأسوية التي خرج بها بعضهم وقد فقدوا الذاكرة، وهم يعانون حالة ذهول تعكس صورة الجحيم في السجون السورية، وحجم الحقد والتعذيب الذي مارسته أجهزة النظام على من اعتقلتهم، وأعدادهم بالملايين.
واستتباعًا لمرسوم العفو، صدر عن وزير العدل في نظام السوري بيان، بتاريخ 5 أيار/ مايو 2022، يذكر فيه أنه تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19/ لعام 2012، بحق جميع المواطنين السوريين، في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان، أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو علاقتهم بجهات دولية.
الحدثان استدعيا كثيرًا من الألم لدى الناس، وخلقا كمًّا من التحليلات ومحاولات الربط والتفسير لدى المتابعين ورجال السياسة والصحافة، في البحث عن دلالات التوقيت والتداعيات وتطورات القضية السورية، في ضوء الوضع الإقليمي والحرب في أوكرانيا وسواهما، حيث بدا واضحًا الوضع المرتبك للنظام السوري، بحكم تورط حاميته روسيا في غزو أوكرانيا، واصطفافه إلى جانبها، راغبًا أو مكرهًا، وتعثّر محاولات بعض الدول العربية في إعادته إلى جامعة الدول العربية، والأهمّ من كل هذا وضعه الاقتصادي المتردي، الذي بات على حافة الانهيار، مع تبدد ادعاءاته الانتصار على “المؤامرة الكونية” التي استهدفته.
ثانيًا: في واقع الحدثين
في 28 نيسان/ أبريل 2022، نشرت صحيفة ذا الغارديان البريطانية، بواسطة مراسلها مارتن شولوف، تحقيقًا صحفيًا استقصائيًا مطولًا مع مقطع فيديو يوضح بالتفصيل وقائع مجزرة بشعة، ارتكبها مسؤول أمني عن قطاع في منطقة التضامن جنوب دمشق، يُدعى “أمجد يوسف”، وهو برتبة مساعد أول من مرتبات فرع التحقيق العسكري رقم 227، بحقّ مدنيين عزّل قادتهم الصدفة السيئة للمرور على حواجز للنظام، بتاريخ 16 نيسان/ أبريل 2013، وكان عددهم 41 شخصًا، بينهم ثماني نساء وعدد من الأطفال. وتوضح عمليات التحقق والاستقصاء التي قام بها البروفيسور أغور أوميت ومعاونته الباحثة السورية من مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية التابع لجامعة أمستردام الهولندية، على مدى ثلاث سنوات، أنّ قوّة نظامية ارتكبت الجريمةَ خارج القانون، مع تخطيط سابق لها، وأن عميلة القتل تمّت بطريقة ساديّة يصعب إيجاد تفسير منطقي لها، وكان المجرم قد برّر جريمته بأنها انتقام لأخيه الذي قُتل في داريّا، في أثناء محاولات قوات النظام اقتحامها.
بعد يومين من تاريخ عدد الغارديان، أصدر الرئيس السوري عفوًا عن معتقلين وفقًا لقانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012، شريطة ألا يكون الموقوف قد قتل إنسانًا. وعلى غير عادة النظام الذي يُعِد قوائم المشمولين ويحضّر لإطلاق سراحهم في مكان محدد؛ تعمّد هذه المرة، لغاية غير مفهومة سوى رغبته في إذلال الناس وإهانتهم، ألّا يُحدد الأماكن التي سيُطلق فيها سراح المفرج عنهم، وقد شتت هذا الأمر الأهالي وجعلهم يتخبطون بالتنقل من مكان إلى مكان، وكان أكبر تجمع للأهالي تحت “جسر الرئيس” في منطقة البرامكة بدمشق، حيث تجمّع آلاف من الذين انقطعت أخبار أولادهم في معتقلات النظام، عسى أن يكون أولادهم من المفرج عنهم، أو أن يحصلوا على أيّ خبر عنهم.
ولكن الصدمة الكبرى هي أنّ عدد المفرج عنهم لم يتجاوز حتى الآن 300 شخص، معظمهم من الذين انتهت مدة حكمهم، أو من أبناء التسويات، وهم بحالة إنسانية مزرية من الوهن والضعف، والأمر المأسويّ أن بعضهم خرج فاقدًا الذاكرة، ولا يعرف شيئًا عن نفسه أو عن ذويه، أو كان في حالة ذهول وكأنه بُعث من القبور. ولم يكتفِ النظام بهذا القدر من الإجرام، إذ دفعته عنجهيته إلى أن يرسل صحفيين وكاميرات تصوير من التلفزيون الرسمي، ليجري مقابلات مع الأهالي المنتشرين تحت الجسر والحدائق القريبة منه، ويحذرهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والابتزاز. وفي اليوم الثالث، حضرت دوريات الأمن وفرقت الناس، فتراجعوا إلى الحدائق القريبة، وما زال كثير منهم في حالة انتظار، متعلقًا بأمل أن عملية الإفراج ستتابع حتى اكتمال الأعداد المشمولة. ومن أكثر المشاهد مأسوية، على سبيل الإيضاح، “أن أحد الآباء كان يصيح: “أخذوا لي ستة أولاد.. بس يرجعوا لي واحد.. أي واحد منهم”، وهناك مشهد آخر لأب وابنه، نزل كل منهما من باص مختلف، وكل منهم لا يعرف أن الآخر معتقل منذ سنوات.
ثالثًا: في الخلفيات والتداعيات
في الخلفيات
مما لا شك فيه أن توقيت نشر التحقيق والفيديو لم يكن عفويًا، فثمة فسحة زمنية واسعة بين انتهاء عمليات التحقق والتقصي وبين تاريخ النشر، ويُرجّح أن هناك جهات دولية مؤثرة حددت توقيت النشر. وربما تكون الرسالة المراد إيصالها للنظام هي “لدينا كثيرٌ من التوثيق لجرائمكم، وهذه العيّنة هي البداية”، وفي حال كان هذا التقدير يقارب الغاية، فإن تلك الجهات غاضبة من النظام لاصطفافه خلف روسيا في الحرب الأوكرانية، ولما أشيع عن تسهيله إرسال مقاتلين ومرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية هناك، وثبات هذه الأخبار أو نفيها متروك للمستقبل القريب.
وبالنسبة إلى توقيت إصدار العفو، فتاريخ النظام السوري يشير غالبًا إلى أنه كان يُوقت الإفراجات مع الأعياد، غير أن كثيرًا من التحليلات حاولت أن تربط المرسوم بزيارته رأس النظام للإمارات، حيث أشارت بعض التسريبات إلى أن دولة الإمارات المتحمسة جدًا لإعادته إلى الجامعة، وتصطدم بالمعارضة السعودية أساسًا، طلبت منه تقديم مبادرة على هذا الصعيد، وهذا قد يكون حاضرًا بدرجةٍ ما، وهو أيضًا الأمر الذي يُلحّ عليه بيدرسون، حيث فشلت الجولة السابعة للجنة الدستورية، ويُحضّر للجولة الثامنة تحت يافطة “خطوة مقابل خطوة”، وكأن أعضاء اللجنة الدستورية من جهة المعارضة لا يمانعون في ذلك، ويحتاجون إلى مبرر للتنازل في نقاط أخرى، يصرّ عليها النظام! أما ما ذهب إليه البعض بأن العفو جاء للتغطية على فيديو مجزرة التضامن، فهو ربط في غير محلّه، وكأنهم غريبون عن طبيعة النظام وطبيعة تفكيره، وتناسوا أنه في سنوات الثورة الأولى، طالما كان يوثق انتهاكاته ويوزعها، بغاية إخافة المتظاهرين وإخماد الثورة، ومنذ متى كان النظام يقيم وزنًا للرأي العام المحلي أو الدولي، وهو الذي أصدر منذ شهر قانون يجرّم التعذيب، وتاريخه يشهد بأنه بزّ أعتى الأنظمة التي مارست تعذيبًا في التاريخ المعاصر، حتى إنه ما زال مطمئنًا لعدم جدية الموقف الدولي في محاسبته، بعد عقدٍ من الزمن ملأه بالانتهاكات الفظيعة.
وقد يكون للوضع الاقتصادي المتردي، وانشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، وزيادة ارتماء النظام في الحضن الإيراني تحسّبًا لاحتمال أن تضطر روسيا إلى التخفيف من دعمها له، دورٌ في أن النظام أراد إلهاء الناس ببعض الإفراجات وتخفيف الاحتقان العام.
في التداعيات
يُجمِع الناس والمحلّلون على أنّ كلا الحدثين والطريقة التي عُمّما بها، مع حجم المتابعات والتعليقات واستهتار السلطة بمشاعر الناس وذوي المعتقلين، قد نكأا جراحًا من الصعب اندمالها، وأنّ تراكم المظلوميات سوف يكون وبالًا على مستقبل البلد، ما لم يُقيّض للمجتمع الدولي من الإرادة والقرار ما يدفعه إلى حلٍّ سياسي يفضي إلى عملية انتقال سياسي وعدالة انتقالية، تنصف كل من ظُلم على يد هذا النظام. ومن جهة أخرى، عبّرت تداعيات الحدث لدى الموالين عن فقدان وزن وتبصر، فهناك كثيرٌ ممن انبروا للدفاع عن أمجد يوسف ولتبرير جريمته، بدعوى أنه كان يواجه “الإرهاب على جبهات القتال”، وظهرت أصوات دانت الإفراج عن “الإرهابين”، وأقوال تعبّر عن السخط من هذه الخطوة، منها أن “أولادنا لم يُقتَلوا لينعم الإرهابيون بالحياة”، وكانت هناك بعض الأصوات من النخب العلوية، التي تَحسب نفسها معارضة بمعنًى ما، راحت تطرح التقسيم حلًا للصراع في سورية، على اعتبار أن السوريين، برأيهم، لم يكونوا ولن يكونوا شعبًا واحدًا، كما بيّنت الأحداث. وهذا تطوّر متقدّم سلبًا عن بعض الأصوات المماثلة، التي كانت تدعو لتعميم تجربة “الإدارة الذاتية” في شمال سورية، كحلّ نموذجي للصراع. وبالرغم من إدراكنا أن كلا النموذجين لا يشكلان ظاهرة وأن أصحابهما لا يمثلون إلا أنفسهم، مع الآخذ بعين الاعتبار أن أغلب الناشطين الموالين للنظام هم من الجيش الإلكتروني ذراع الأجهزة الأمنية وأن جُلّ ما يقولونه ويكتبونه يأتي بتوجيه تلك الأجهزة؛ فإن اللوحة تشير إلى أن الموالين يعانون حالة قلق حقيقي بعد انكشاف أن “النصر” الذي يدعيه النظام ما زال وهمًا، وأن أي تغيير في درجة تحالفه مع كل من إيران وروسيا، أو في موقف الغرب منه، سيودي به، لكن دون أن نتغاضى عن وجود بعض النخب المحسوبة على المعارضة، التي حاولت النفخ في نار البعد الطائفي للحدث.
رابعًا: خلاصات واستنتاجات
1- إن قضيّة المعتقلين، في عرف النظام السوري، هي قضية عويصة، وهو يغلّفها دائمًا بالغموض، كي لا تنكشف حقيقة الانتهاكات التي ارتكبها بحقّ من يعتقلهم، ومنها عمليات التصفية المنهجية، ولذلك لا يقدّم النظام أي معلومة عن أعداد المعتقلين في سجونه ووضعهم ومصيرهم، كما يطالب أهالي المعتقلين، وإذا تجاوزنا الحالة المزرية التي خرج بها المعتقلون، على قلتهم، حتى الآن، ثم تجاوزنا أن أعمار كثير منهم هي دون الخامسة والعشرين (أي أنهم اعتقلوا وهم أطفال) تبقى هناك المشكلة الأعقد المتمثلة بحجم عمليات التصفية بكل صورها، داخل الأقبية أو السجون، في السنوات الثلاث الأولى للثورة، وهي عمليات شملت أعدادًا يصعب تخيُّلها، حيث اعتُقل عدة ملايين، وهناك قرابة مئتي ألف شخص يُصنفون في خانة الاختفاء القسري. وفي هذا الخصوص، يقول رئيس لجنة التحقيق الأممية المعنية بسورية باولو بينيرو: “إن الاعتقال في سورية اليوم هو بمثابة الاختفاء القسري”، وهو يعني التصفية والاختفاء من الحياة، والكلام ذاته قاله اللواء جميل الحسن (مدير إدارة المخابرات الجوية السابق)، في زيارته الأولى إلى درعا، بعد أربعة أشهر من خروج قوات المعارضة منها: “كلّ من له سجين قبل الـ 2014 فلينساه”، وعلى ذلك؛ فإن خروج بضع مئات أو بضعة آلاف، وهو ما لم يحصل في هذا العفو، لا يُغيّر من مأسويّة الحالة.
2- ترافق صدور القانون مع حالة من الإرباك والتخبّط والغموض، وظهرت الحالة ذاتها مع بيان وزير العدل الذي لاقى ضجة أوسع من العفو ذاته، نظرًا إلى حجم مذكرات الاعتقال على مختلف درجاتها، وأعدادها بالملايين، وهي تشكّل مصدر قلق حقيقي لدى المطلوبين في الخارج، وليس هناك ما يدعوهم للثقة بوعود النظام أو بقوانينه، حيث إن كثيرًا من الذين عادُوا إلى “حضن الوطن” في السنوات القليلة الماضية قد اعتُقلوا وأُخفوا، بل إن بعضهم تعرّض للقتل. وكلّ هذا يدلّ على أن النظام لا ينوي تغيير نهجه حيال المعتقلين في سجونه، وكعادة النظام بأن يقيد كل قانون يصدره باستثناءٍ يُفرغه من مضمونه، فقد ربط الإفراج أو وقف الملاحقة أو سواها، بألا يكون تسبب بقتل إنسان، ولم يثبت انتماؤه للمنظمات الإرهابية. ولا يخفى على أي سوري براعة الأمن السوري بتلفيق التهم التي يريدونها وإلباسها لكل من يريدون النيل منه.
3- وُجّهت كثير من الانتقادات إلى المرسوم، الذي سمّى المفرَج عنهم “إرهابيين”، والتساؤل المطروح: إذا كانوا إرهابيين، فلماذا يفرج النظام عنهم، وهو يدّعي محاربة الإرهاب؟! وإذا لم يكونوا كذلك، فهل سيحاسب من كان سببًا باعتقالهم وتعريضهم لما عانوه كما يفترض؟!
4- يدرك النظام تمام الإدراك أن من يقف إلى جانب المهزوم، في أي حربٍ، كما يُبين تاريخ الحروب، سوف يتحمل جزءًا من تبعات تلك الهزيمة. وإنّ تعثر الحرب الروسية على أوكرانيا، مع عدد الدول التي تقف إلى جانب أوكرانيا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو ومجموعة الدول السبع، وإصرار هذا التحالف غير المعلن على إلحاق خسارة من مستوى استراتيجي بروسيا، كما يُرجّح، جعل النظام السوري مربكًا، فأراد توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة، تُبرر موقفه وتظهره قابلًا للتعاطي مع المطلب الغربي بتغيير سلوكه، الأمر الذي كان يرفضه منذ مذكرة كولن باول، عام 2003.
5- مرة أخرى، تؤكد المعارضة التمثيلية استقالتها من دورها، إلا في حدود ما توجّهها إليه الدول المؤثرة، فقد كان الحدثان فرصةً مناسبةً لتفعل شيئًا، أقلّه على صعيد الإعلام، حيث لم يصدر بيان ولا خطاب للجهات الدولية لفضح ممارسات النظام، وإعلان أن قضية المعتقلين قضية غير تفاوضية، حتى في إطار اللجنة الدستورية، لكن على ما يبدو أن المثل القائل “في الصيف ضيعت اللبن”، سيبقى برسمهم إلى أجل غير معروف.
مركز حرمون
———————–
عندما خدعنا النظام السوريّ وقال إنه سيفرج عن المعتقلين/ كارمن كريم
تعلّم السوريون طريقة للتعايش مع اعتقال تعسفي أو مفاجئ، لذلك يسعى كلّ من اعتقله النظام إلى معرفة الفرع الذي أوقف فيه، من خلال محاولة استراق النظر أو سؤال السجناء.
لا تزال آلاف العائلات السورية تنتظر خبراً عن أبنائها المعتقلين والمغيبين قسراً، لم يكن العفو الأخير الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد سوى سكين جديدة في أجساد السوريين، إذ كشف النقاب عن مأساة قابعة في كلّ مكان من حولهم، إنها مآسي عائلات معتقلين يفوق عددهم 130 ألفاً.
النظام السوري لا يساعد شعبه
قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم الأحد 16 أيار/ مايو إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصاً، وما زال لديه حوالى 132 ألف معتقل ومغيب قسراً، واعتبر التقرير أن العفو شكلي ولا يختلف عن قرارات العفو السابقة، فمعظم من أفرج عنهم هم مدنيون ألصقت بهم تهم الإرهاب بعد اعتقالهم بشكل تعسفي. كما أن هناك ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، إلى 18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتان، وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات. هذه الأرقام تشير إلى الانتقائية في تطبيق العفو، عبر الإفراج عن مدنيين بعيداً جداً من زنازين معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين والمعارضين. بعد سنوات من المجازر والاعتقالات والأكاذيب يصعب على السوريين تصديق أن النظام قد يقوم بأي خطوة إيجابية نحو الناس، لمجرد رغبته في مساعدتهم، كل ما يقوم به نظام الأسد هو إما لرسم مستقبل أفضل له أو لإبعاد الشبهات منه. وإن كان النظام قد سعى من خلال عفوه الأخير إلى تغييب صدى مجزرة التضامن المهولة فيبدو أنه نجح إلى حد كبير، فالبحث عن الناجين الأحياء قد يستمر أكثر من موتٍ لا عودة منه، أدرك النظام هذه المفارقة البسيطة، فعمل على اللعب على الأمل الذي مات لدى آلاف العائلات وبإحيائه أبعد نفسه إلى حد كبير من المجزرة، وتحايل على الألم بصنع ألم آخر وبإلهاء الناس بكثرة الأوجاع.
من جهة أخرى، قال التقرير إن العفو لا يشمل الغالبية العظمى من المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم، ولم تتم إحالتهم لأي محاكم، وقد مضى على اعتقال كثر منهم سنوات. أما عن المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم فلا معايير واضحة لاختيارهم بحسب التقرير، كل هذا يزيد من تعقيد الوضع السوري في ظل عفوٍ كان يفترض أن يخرج الآلاف من السجون إلا أن العكس حدث والنظام يُخرِجُ المعتقلين ببطء، بهدف التعتيم على قضايا أخرى.
يحرص النظام على إخفاء اسم المكان الذي يسوق الأشخاص إليه، قال لي معتقلون سابقون: “لو عرفتِ مكان احتجازك فتأكدي أن نصف قضيتك حُلت”.
التعايش مع الاعتقال التعسفي
وفي حين يصرّ النظام على نسب كل الأحداث خلال العقد الفائت إلى إرهابيين وعملاء مدعومين من الخارج، يقبع في سجونه آلاف المعتقلين الذين أجبروا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها حتى، إذ أكد التقرير أن النظام السوري هو الجهة التي أجبرت المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، شهادات من خرجوا من المعتقلات على مر السنين مرعبة، عذاب لا نهائي، إهانات وتهديدات باغتصاب الأمهات والأخوات، ثم يحاكمهم النظام بناءً على اعترافات أجبرهم على قولها، وبعد هذا كله يصدر عفواً عن جرائم اختارها هو لهم!
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن هناك ما لا يقل عن 86792 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار/ مارس 2011 حتى آب/ أغسطس 2021. ووفقاً للتقرير أظهرت المقارنة أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 في المئة من حصيلة المختفين قسرياً، وهي نسبة متدنية للغاية، لكنها إثبات في الوقت ذاته على أن النظام ما زال يحتفظ بآلاف المغيبين قسراً، وأن هؤلاء المغيبين موجودون بالفعل في سجونه، عكس الأكاذيب التي روج لها. لكن الأزمة هي في استمرار إطلاق سراح المعتقلين بهذه الوتيرة البطيئة جداً، إذ يعني ذلك عشرات السنوات من الانتظار حتى يفرج عن المعتقلين جميعاً، في حين لا يمكن وصف معاناة ذوي المختفين قسراً، الذين يعيشون منذ سنوات ما بين التعلق بأمل ظهور أحبائهم أو الاستسلام لفكرة فقدانهم.
تعلّم السوريون طريقة للتعايش مع اعتقال تعسفي أو مفاجئ، لذلك يسعى كلّ من اعتقله النظام إلى معرفة الفرع الذي أوقف فيه، من خلال محاولة استراق النظر أو سؤال السجناء، إذ يحرص النظام على إخفاء اسم المكان الذي يسوق الأشخاص إليه، قال لي معتقلون سابقون: “لو عرفتِ مكان احتجازك فتأكدي أن نصف قضيتك حُلت”.
يعتمد السجناء على إخبار عائلات بعضهم عن أماكن اعتقال أبنائهم فيما لو خرجوا أحياء ولكن إن لم يكن السجناء يعرفون مكان اعتقالهم فلا فائدة من الخروج أو الاتصال برقم هاتف حفظه المعتقل بصعوبة، يجب أن يقول اسم الفرع الأمني ليأتي بعدها دور العلاقات والأموال في إنقاذ المعتقل، تدفع العائلات آلاف الدولارات فقط لمعرفة مكان أبنائها لا أكثر، دون أن تُمنح فرصة لسماع صوتهم حتى.
الأمل، هو ما يعيش عليه آلاف السوريين اليوم حرفياً، أمل بخروج ابنٍ معتقل، أو نجاةِ آخرٍ من مجزرة، أو ظهور مفقود من مكان ما، لكن تبقى كلها آمال مرهونة بمزاج نظام الأسد ومصلحته وحاجته إلى القفز عن مجزرة أخرى إلى الأمام.
درج
———————–
=================
تحديث 24 أيار 2022
————————
قرابين التضامن: عن الضحايا وميدان الجريمة/ عروة خليفة
شهد حيّ التضامن في الجنوب الدمشقي كثيراً من الفظائع. لم تكن المجزرة التي كشف عنها التحقيق الذي نُشر مؤخراً وحيدةً، لكنّ فظاعة التسجيل، الذي يوثق اللحظة الأخيرة من حياة سوريين وفلسطينيين، كانت قادرة على استعادة ذاكرة ما حدث وظل يحدث لسنوات في البلاد.
كانت منطقة التضامن ومحيطها في جنوب دمشق تنبض بالحياة قبل أن يتم تحويلها إلى ميدان للموت: الناس يذهبون صباحاً إلى الفرن، والموظفون المتعبون يتعلقون ببعضهم بعضاً وبالسرافيس للذهاب إلى العمل، وباعة متجولون ومحلات ألبسة أرخص أسعاراً في مخيم اليرموك القريب. ارتكب القتلة جرائمهم في تلك المنطقة طوال أشهر وسنوات، تم قتل واعتقال وإخفاء الآلاف، ومنهم واحدٌ وأربعون ضحية كشفَ تحقيق قرابين التضامن عن أسماء قتلتهم، دون أن يتم الكشف عن أسماء أغلبهم حتى الآن. قصة هؤلاء الضحايا جزء من وقائع القتل والاعتقال والتغييب في جنوب دمشق، وهذا النص جزءٌ من حكاية الضحايا وحكاية المكان.
حيّ على أنقاض هزيمة 67
استقبل حي التضامن منذ إنشائه، أواخر ستينات القرن الماضي، موجات النازحين من المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد هزيمة حزيران 1967، ليسكنوا إلى جانب أولئك الذين استقبلهم مخيم اليرموك الأقدم (تم إنشاؤه بداية الخمسينات) من فلسطينيين تم تهجيرهم من مدنهم وقراهم ولجأوا إلى سوريا في نكبة العام 1948. سكن المهجّرون الجدد، من أبناء الجولان السوري وبينهم فلسطينيون تم تهجيرهم عام 67 أيضاً، في محيط مخيم اليرموك، وكثيرون منهم سكنوا إلى الشرق والشمال الشرقي من شارع فلسطين، الذي يفصل بين حي التضامن ومخيم اليرموك.
لم يبقَ حي التضامن على حاله بالطبع، ونتيجة انخفاض تكاليف السكن فيه، فإنه كان يستقبل موجات عديدة من السكّان القادمين للعمل والعيش في العاصمة من مختلف المحافظات السورية، من درعا جنوباً إلى إدلب شمال غرب البلاد. وقد قام التوسع العشوائي للحي بدور أساسي في عملية دمج السكّان المتنوعين بشدة، غير أن عدداً من الحارات الأقدم نمت على أساس مناطقي ارتبط أيضاً بالانتماء الطائفي في حالات نادرة، أبرزها شارع نسرين، الذي سُمّي على اسم صيدلية مشهورة فيه، وكان يضم أبناء الجولان النازحين من قرية عين فيت المحتلة، وأبناؤها وبناتها ينحدرون من الطائفة العلوية.
كان التضامن عموماً منطقة أقل تكلفة للعيش من أحياء المدينة الأغنى، والتي ضاقت بسكّانها أصلاً، وذلك من دون تفاوتات طبقية كبيرة بين سكّانه حتى تسعينات القرن الماضي. إلا أنّ الأمر بدأ بالتغير منذ ذلك الوقت، إذ توسَّعَ ليضم حارات خارج المخطط التنظيمي للحي الذي يسمح ببناء الوحدات السكنية، ما ترك فوارق كبيرة أحياناً في أسعار العقارات. بدأت تلك الفوارق تترجم نفسها طبقياً منذ ذلك الحين ببطء، ومع ضمّه موجات من السكّان الآتين من أحياء أخرى من العاصمة دمشق نتيجة التوسع السكّاني، أخذَ الحي نفسه بالتغير، ليصبح أكثر تنوعاً على الصعيد الطبقي والمناطقي.
يمتد حي التضامن اليوم بين شارع فلسطين غرباً وبلدتي يلدا وببيلا جنوباً وشرقاً. وشارع فلسطين وهو شارعٌ قريبٌ من شارع مخيم اليرموك الرئيسي، يتفرع مثله عن ساحة تعرف بين السكّان بساحة البطيخة (الساحة تضم تمثالاً للكرة الأرضية). أما يلدا وببيلا فتُعدّان أولى البلدات أو الاحياء التابعة لمحافظة ريف دمشق من هذه الجهة. إلى شمال حي التضامن، يقع حي الزاهرة الدمشقي. ويتصل بالتضامن أيضاً حي السليخة من الشرق، وهو تابع بمعظمه لمحافظة ريف دمشق. يمتدّ التضامن فعلاً على أراضٍ تتبع إدارياً لمحافظتين؛ دمشق وريف دمشق.
كان سوق مخيم اليرموك، والأسواق في شارع فلسطين والشوارع المتفرعة منه باتجاه اليرموك، هي المركز الأساسي للحياة الاقتصادية بالنسبة لأحياء التضامن والحجر الأسود وبلدات جنوب دمشق، بالإضافة إلى مخيم اليرموك نفسه. كانت تلك الأحياء والمناطق أقرب إلى بعضها بعضاً من أحياء العاصمة الأخرى، وساهمت الفروق الطبقية بينها وبين أحياء العاصمة الأغنى القريبة أو الأبعد في وحدة الحال تلك. بين دمشق وفلسطين، كانت المنطقة أقرب إلى فلسطين.
لم يحظَ حيّ التضامن بأي رعاية حكومية، بل عاش إهمالاً مماثلاً لما عاشته معظم المناطق الأفقر. كان أحسنَ للعيش من بعض الأحياء العشوائية الأخرى مثل عش الورور ومزة 86، لكنّ مستوى الحياة فيه ظلّ أقلّ بكثير بالمقارنة مع أحياء دمشق الأغنى. كان غالبية سكانه من طبقة وسطى منهكة تقترب من الفقر، كانوا فقراء قليلاً أو كثيراً، لكن تلك الفوارق كانت تُمحى عند تمشيهم في كورنيش الميدان أو في حي المزرعة، وهي أحياء أصبحت مع الوقت حكراً على العائلات الأغنى في دمشق، الأغنى إلى مستوى يجعل سكّان التضامن كلّهم من الفقراء.
من الشبيحة إلى الدفاع الوطني
مع بداية الثورة السورية ربيع العام 2011، كان الضغط الأمني شديداً وسط العاصمة، في الأحياء المركزية والساحات العامة الرئيسية، حتى أنه وصل إلى حد استخدام سلاح متوسط ضد متظاهرين حاولوا الوصول إلى تلك الساحات. وقد أدّى ذلك إلى تركز المظاهرات والحراك المدني في الأحياء الطرفية للعاصمة دمشق، وما جاورها من بلدات ريف دمشق. تحولت أحياء مثل برزة إلى مركز للتظاهرات، بالمثل كانت أحياء التضامن وشارع فلسطين والحجر الأسود وبلدات يلدا وببيلا مركزاً للحراك السلمي والمظاهرات، الأمر الذي دفع النظام إلى البدء بالاعتماد على سكّان من تلك الأحياء كقوة بشرية مساندة لعناصر الأمن، الذين باتوا ينتشرون على مدار الساعة بلباس مدني في كل شوارع العاصمة لقمع التظاهرات. بدأ السكّان والمتظاهرون بإطلاق اسم الشبيحة على تلك المجموعات، وهو اسم مستمدّ من عناصر عصابات مرتبطة بأفراد من عائلة الأسد في اللاذقية، نشطوا في التهريب والسرقة والتعدي على السكّان خلال الثمانينات وبداية التسعينات (أرجحُ التفسيرات لتسمية شبيّحة هو أنها من شَبَح، وهو اسم محلي لسيارة مرسيدس S600 التي عرف بها المسؤولون، خاصةً المسؤولون الأمنيون في سوريا).
عبد الله الحريري ناشط وطبيب من المنطقة، عاش سنوات حصار مخيم اليرموك ولاحقاً بلدات جنوب دمشق. يقول للجمهورية: «عمل النظام على تطويق حي التضامن من خلال مجموعات الشبيحة، من شماله كانت المجموعات المرتبطة بشارع نسرين، فيما كانت هناك مجموعات تعمل مع الجبهة الشعبية-القيادة العامة من جهة شارع فلسطين بقيادة شخص اسمه سعيد محاد، وأخرى مرتبطة بفرع فلسطين (التابع للمخابرات العسكرية) يتزعمها شخص اسمه أبو محمد سريّة من جهة الجنوب. استقبل القسم الجنوبي من حي التضامن، إضافةً للتظاهرات والنشاط السلمي، أعداداً كبيرة من النازحين خاصةً من مدينة حمص. وقد عملنا هناك على تأسيس عيادات سرّية لمعالجة المصابين خلال المظاهرات، أو نتيجة استهدافات القناصين الذين نشرتهم مجموعات الشبيحة، وذلك في ورش كانت تعمل نهاراً في الخياطة، ونُجري فيها ليلاً عمليات الإسعاف وعمليات جراحية صغرى».
بدأت الأفرع الأمنية المسؤولة عن المنطقة تنظم تلك المجموعات ضمن ما يسمى باللجان الشعبية، وتسلّحها بأسلحة خفيفة بعد أن كانت تستخدم الأسلحة البيضاء والهراوات في قمع المتظاهرين، وبدأت أسماء عناصر من تلك الميليشيات أو من متعاملين مع فروع أمنية بالبروز نتيجة الانتهاكات التي قاموا بها.
كان عادل قطف يستخدم اسماً مستعاراً هو حاتم الدمشقي خلال عمله في المجلس المحلي لحي التضامن، وخلال نشاطه الإعلامي في الفترات التي سيطر فيها الجيش الحر على أجزاء واسعة من الحي. يقول قطف خلال حديثه للجمهورية: «استطعتُ خلال فترة وجودي في الحي، وأنا أحد ساكنيه، توثيق عدة مجازر قام بها النظام. كانت الميليشيات بقيادة فادي صقر، التي تحولت إلى مسمّى الدفاع الوطني أواخر 2012، ترتكب انتهاكات وجرائم بمساعدة دوريات تابعة لأفرع المخابرات العسكرية. كان هؤلاء الذين ظهروا في فيديو مجزرة التضامن، بمن فيهم أمجد يوسف، معروفين لدينا في الحي من خلال ارتكابهم المتكرر للانتهاكات وعمليات الاعتقال والتصفيات بحق ناشطين سلميين، وقيامهم بهدم أبنية في منطقة السليخة شرق التضامن. لقد وثقتُ خلال عملي الصحفي أسماء وقصص ضحايا أكثر من سبعة مجازر تم ارتكابها من قبلهم».
كان العامل الطائفي يلعب دوراً في تشكيل تلك المجموعات، لكنّه حسب الناشطين الذين عايشوا تلك الفترة لم يكن وحيداً. عبد الله الحريري يشرح خلال حديثه مع الجمهورية هذا التفصيل: «قد يكون العامل الطائفي أساسياً في تشكيل تلك المجموعات في البداية، لكنّها لم تكن بذلك المعنى صافية طائفياً. تعود أصول عائلة أحد الشباب الذين نعرفهم في المنطقة إلى عائلة سنيّة من الجولان، وكان بحكم الجوار والصداقات مرتبطاً قبل الثورة بأحد أكبر رموز الشبيحة في المنطقة لاحقاً، وهو فادي صقر. بحكم تلك العلاقات، استطاعوا اجتذابه لمجموعات الشبيحة تلك في بداية الثورة. لاحقاً، ترك ذلك الشاب، الذي لا أريد ذكر اسمه خوفاً على أهله، مجموعاتِ الشبيحة بعد أن شاهدهم يطلقون النار مباشرة على المتظاهرين الذين يخرجون من أحد الجوامع. في حديث بيننا بعد سنوات، ذكرني هو بأنه كان مع أحد المجموعات التي قامت بضربي خلال مظاهرة قمنا بها».
يتابع عبد الله الحريري حديثه للجمهورية عن تلك المجموعات: «في المرحلة اللاحقة التي بدأ فيها تنظيم عمل الشبيحة، لا يمكننا فصل ما كان يجري في حي التضامن عن عموم منطقة جنوب دمشق، وذلك بسبب التزامن والتنسيق في تشكيل اللجان والمجموعات في حي التضامن ومخيم اليرموك، وحتى في منطقة السيدة زينب إلى الجنوب».
يقول الحريري: «لاحقاً عندما تم تنظيم مجموعات الشبيحة في لجان، وأنشأوا الحاجز الأول لهم في شارع نسرين عند مطعم البركة عام 2012، كان دور هذا الحاجز تحديد الحركة ومراقبة داخل حي التضامن لمنع الحراك ضمنه. وهو ما فعلته باقي المجموعات في الأحياء المجاورة، كما في حالة مجموعات القيادة العامة (الجبهة الشعبية – القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل) في مخيم اليرموك».
مختفون في غياب مظلم
حصلت مجموعات الشبيحة تلك على سلطات واسعة في المنطقة، نافست من خلالها نفوذ ضباط من رتب عالية في الجيش وحتى بعض أجهزة الأمن، ما انعكس على شكل زيادة في الاعتماد عليها في عمليات القمع وفي حماية حدود سيطرة النظام في المنطقة، بعد أن كانت مجرد رافد للقوى الأمنية خلال قمع الاحتجاجات والمظاهرات في عموم البلاد.
حازم يونس ناشط فلسطيني من مخيم اليرموك، كان يعمل في سفارة فلسطين (سفارة السلطة الفلسطينية في سوريا، وأصبحت تعرف باسم سفارة فلسطين بعد اعتراف سوريا بالسلطة كدولة مستقلة)، شاركَ في اجتماعٍ باسم السفارة كان يحضره ضباط رفيعو المستوى من جيش النظام أحدهم برتبة لواء، كما حضره فادي صقر متزعم مجموعات الشبيحة والدفاع الوطني لاحقاً. يقول حازم: «كان فادي صقر يوجه الإهانات للّواء دون أن يرد عليه الأخير. كانت سلطة صقر واضحة للعيان، كما كانت مجموعاته فوق أي محاسبة من قبل النظام».
بدأ الناس في تلك الفترة بالاختفاء على حواجز اللجان الشعبية حتى قبل تسميتها باسم الدفاع الوطني، وهو الاسم الرسمي اللاحق الذي عرفت به تلك المجموعات منذ أواخر عام 2012، بعد أن حظيت بدعم إيراني كبير. وبدأت قصص الناجين من الفظائع المرتكبة بالظهور. يحكي عبد الله الحريري قصة سمعها من طفل مصاب، جاء به أهله إلى المشفى الميداني حيث كان يعمل في مخيم فلسطين منتصف العام 2013: «قبل تطبيق الحصار الكامل على مخيم اليرموك، جاء إلينا في النقطة الطبية هناك طفل عمره لا يتجاوز 15 عاماً، كان قد استطاع الهرب من لجان الدفاع الوطني في شارع نسرين، بعد أن اعتقلوه عند حاجز الفرن الآلي وأدخلوه إلى محل قديم كانوا قد حولوه إلى سجن للاعتقال. استطاع الطفل الذي كان صغير الحجم الهروب من شباك صغير في الدكان (شباك المنور) والرجوع إلى المخيم، وقد روى لنا بأنّه شاهد جثامين ثلاثة أشخاص قتلوا ذبحاً في الدكّان، فيما كان الدمُ يغطي كل جدران المكان. كان الطفل قد تعرَّضَ لتعذيب بانت آثاره على جسمه، مثل مناطق مزرقة على الظهر وكدمات على الوجه».
يتذكر حازم يونس أيضاً قصص من قُتلوا أو اعتقلوا في المنطقة على يد تلك الحواجز والشبيحة: «أبو علاء جودة قتل برصاص قناص حاجز الريجة. أبو إبراهيم الخطيب خرج للحصول على طحين فاعتقلوه من على حاجز نسرين. أما المجرم أمجد يوسف فقد قام بقتل مدنيين على حاجز شارع نسرين عندما قتل أخوه في إحدى المعارك. أيضاً، روى لي صديقٌ في السويد هنا قصة عن عائلة خالته التي تعيش في مجموعة من أربع أبنية يقطنها فلسطينيون في حي التضامن، يقول إن الشبيحة اعتقلوا في اليوم نفسه كلّاً من موّلد الخالد العبد الله، ديب الأحمد، إلهام العبد الله، إنعام العبد الله، ياسمين العبد الله وابنها الطفل عبادة العبد الله، الذين اختفوا جميعاً دون أي أثر بعد ذلك».
كانت الإهانات والمضايقات والابتزاز المالي أساس عمل الحواجز التي انتشرت في مداخل حي التضامن ومخيم اليرموك، كما كان العناصر يختطفون المدنيين دون أي رادع. يروي حازم يونس قصة فتاة اعتُقلت مع خطيبها على حاجز مدخل المخيم، فقط لأنّ خطيبها ردّ على إهانة أحد العناصر لخطيبته: «عند رد خطيب الفتاة على عناصر الحاجز، قاموا فوراً باعتقالهما وإخفائهما، وعلى الرغم من أنّ قريب الفتاة كان في منصب رفيع ضمن حركة فتح، وعلى الرغم من مطالبات السلطة الفلسطينية العديدة بالإفراج عن المعتقلين، لم يصل أي خبر منهم ويبقى أهلهم إلى اليوم من دون أي معلومات. لقد كانوا يريدون دخول مخيم اليرموك للاطمئنان على عائلاتهم التي أصيب بعض أفرادها نتيجة قصف طائرة ميغ للمخيم، وذلك في أولى حوادث قصف الطيران للأحياء المدينة في سوريا آن ذاك، لكن الأمر انتهى بهم مُغيَّبين حتى اليوم».
خلال تلك الفترة، لعب شبيحة شارع نسرين دوراً أساسياً، فكلّ المعتقلين على الحواجز في المنطقة كان يتم أخذهم إلى حاجز الفرن الآلي في الشارع أو الحاجز الآخر الذي أُنشئ في منتصفه، وهو ما كان يدل على السلطة التي امتلكها الشبيحة أو عناصر الدفاع الوطني لاحقاً.
وثَّق عادل قطف وزملاؤه، خلال عملهم الإعلامي في التضامن، العديد من الاعتقالات التي جرت قُبيلَ المجزرة التي كشف عنها تحقيق قرابين التضامن: «قبل أيام من حدوث تلك المجزرة، اعتقلت دوريات من المخابرات العسكرية ومجموعات تابعة للشبيحة ثلاث عائلات تسكن خلف جامع عثمان بالقرب من مكان حدوث المجزرة. كان هناك زوجان حديثا الزواج، وعائلة لديها طفل واحد وعائلة مع طفلين. اختفوا جميعاً منذ ذلك الوقت بعد أن اقتحم الشبيحة منازلهم وأخذوهم. كان صديقي من بينهم، كان يحاول تأمين منزل خارج التضامن قبل أيام، لكنّ تلك المداهمة أنهت بحثه ذاك، ليبدأ بحثنا نحن عن مصيره ومصير العائلات التي لا نعرف عنها شيئاً حتى اليوم».
بعض العائلات بدأت بالتعرف على أبنائها من خلال فيديو المجزرة الذي تم تسريبه. كشفت المشاهد الصادمة والفظيعة عن مصير عدد من ضحايا المجزرة، أحدهم كان وسيم صيام ابن مخيم اليرموك. يتذكر عمر صيام اللحظات التي سبقت اختفاء ابنه وسيم: «كان وسيم ذاهباً لجلب الخبز من الفرن الآلي في حي التضامن ليعود قبل إغلاق حاجز المخيم في الساعة الواحدة ظهراً، إذ كان المخيم حين ذاك محاصراً بشكل جزئي، وتُفتَح الحواجز لمرور المدنيين لساعات معينة من كل يوم. في الرابع عشر من شهر نيسان عام 2013، في الساعة الواحدة إلا ثلث، اتصلت بوسيم من أجل حثّه على العودة بسرعة إلى المخيم قبل إغلاق الحاجز. ردّ عليَّ بشكل غريب لم أكن معتاداً عليه منه، قال لي: ماشي ماشي، وأغلق الهاتف. بعد ساعات بدأنا بالسؤال عن وسيم، كان هاتفه قد أُغلق ولم نعلم عنه شيئاً منذ ذلك الوقت إلى أن شاهدناه في فيديو المجزرة. كنّا قبل فترة قد استخرجنا قيداً عائلياً بعد أن قام أفراد من أقاربنا بالمثل وحصلوا على شهادات وفاة لأبنائهم المعتقلين. كان وسيم حيّاً في السجلات». «تأملنا كثيراً»؛ تقول والدة وسيم التي شاركت والدهُ الحديث معي.
لم يتم التعرف على أغلب ضحايا مجزرة التضامن، التي تم الكشف عن مرتكبيها وعن تفاصيل منها في التحقيق الذي عملت عليه أنصار شحود وأور أونغور، وهي واحدة فقط من سلسلة مجازر، بعضها مصوّرٌ في فيديوهات أخرى ولم تُعرَف حتى اليوم أسماء مرتكبيها، كما لم تُعرف أسماء ضحاياها بعد. ضحايا سوريون وفلسطينيون، من كل سوريا وكل فلسطين، قتلوا وحرقت جثامينهم بوحشية لا يمكن تخيلها، فيما يبقى ضحايا الاختفاء القسري في جنوب دمشق وكل سوريا في الغياب، وأهاليهم لا يملكون القدرة على الوصول إلى أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة . وقد كشفَ الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لدى النظام، قبل أسابيع قليلة، عن أشخاص ظلّوا لسنوات مغيبين في سجون مثل صيدنايا. لا نعلم العدد الحقيقي للمختفين قسراً في سوريا. تشير بعض الأرقام إلى أكثر من مئة ألف، لكنّ الجهات الحقوقية نفسها تقول أيضاً إنّها لم تستطع توثيق كل الحالات التي قد يفوق عددها ذلك التقدير بكثير. وربما لا نملك الكثير لنفعله من أجل كشف مصيرهم وإطلاق الأحياء منهم، لكن رواية حكاية ضحايا التغييب هي نضالٌ ضد المُغيِّب، الذي يريد لرجال ونساء وأطفال من ضحاياه أن يختفوا في النسيان.
—————————
توقيف أمجد يوسف: النظام بين الدولة والعصابة/ حسام جزماتي
رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على توقيفه، لم تعلن سلطة الأسد عن احتجازها للمساعد أول أمجد يوسف، المتطوع في شعبة المخابرات العسكرية، والمرتكب الأساسي لمجزرة حي التضامن الشهيرة.
لا تُعرف، حتى الآن، الدوافع الحقيقية لهذا الإجراء ولا النتائج المنتظرة له. طالما أن يوسف لن يكون في وارد إنكار جرائمه الثابتة التي كانت تبدو له، حتى وقت قريب، نوعاً من السلوك المعتاد الذي لا يستأهل أي عقوبة. خاصة أنه الآن بين أيدي «زملاء» يعرف تماماً ما يستطيعون فعله طالما أتت الأوامر من «المعلم»، أي «معلم».
ربما جاءت النصيحة من بعض حلفاء النظام ممن يُبدون حرصاً ظاهراً على ترقيع أطلال «الدولة» السورية و«مؤسساتها» المفترضة، لا سيما أمام فضيحة بهذا الحجم والفجاجة والذيوع.
غير أن معلَماً ثابتاً من ملامح الحكم الأسدي، غيّبته السنوات الأخيرة بشدة، يجدر أن لا يبعد عن الذهن في تحليل سلوك كهذا. وهو تكوّن هذا الحكم من خلطة عجائبية هجينة من عنصرَي الدولة والعصابة اللذين يتبادلان الأدوار دائماً.
تعود مورثات هذه الخلطة إلى عهد الأسد الأب الذي تسلم، عام 1970، دولة لم تكن قد تهتكت خلال السنوات السبع المنصرمة من حكم البعث رغم القمع والتجاوزات. وقد ضمت الدولة المقصودة ذاكرة قريبة من الحريات، وموظفين معتّقين في مراكز مؤثرة في الوزارات، ونقابيين لم يستمرئوا الذل، وبقايا حية لأحزاب، وشركاء في «الحركة التصحيحية» التي رفعته إلى السلطة ظنوا، لسوء تقديرهم، أن لهم حصة من الحكم والحزب. والأرجح أنه تعب، نسبياً، حتى استكمل ترويضها قرابة منتصف الثمانينيات.
لكن هذا مجرد جزء من الحكاية وإن كان بارزاً. إذ يبدو أن لعبة تفكيك الدولة استهوت الأسد المنعزل في مكتبه، بطبيعته النظامية الأصلية ودواعي تجاهله القانون مراراً بغرض الاستمرار على العرش، فرأى أنه من المفيد الاحتفاظ بكلا الورقتين في جيبه، متلاعباً بمسؤوليه إذ يراوح بين إبراز هذه أو تلك بشكل محيّر. فهو الوحيد الذي يمتلك تفسير مراوغته وسر انقلاباته غير المنتظرة. ومن المعروف أن هذه السمة، أي عدم قدرة «الخصم» على توقع سلوكك، هي إحدى وصفات الانتصار. وفي الديكتاتوريات الانقلابية فإن أعوانك هم أقرب خصومك.
عرف رجال حافظ الأسد هذه الخصلة فيه فاستعدوا للاحتمالات المتناقضة دوماً. فقد تخرج من لقائه بالتكليف بمنصب أعلى أو مهمشاً إلى المنزل، وربما تحال للمحاسبة في حالات قصوى. ولكل من الحالات لديه مبرراته المنظمة التي قد يسردها بصوته الخفيض. أما القلة القليلة ممن عرفوه بعمق، نتيجة العشرة الطويلة، فقد حرصوا على إخفاء قدرتهم على التنبؤ بقراراته وتركوا له الاستمتاع بالغموض المفترض للمتأله الذي يخفض ويرفع.
خلال عقود من الحكم تسربت هذه الآلية في السلوك من القصر الجمهوري في حي المهاجرين إلى مفاصل النظام. ورغم أن آلاف المقلدين لم يبلغوا درجة براعة «المؤسس» إلا أنهم، بما استطاعوا اقتباسه منها، كانوا قادرين على إدهاش من حولهم بالتساهل في تطبيق القانون حيناً، والتبرز عليه أحياناً، ونفض الغبار عنه فجأة وإشهاره في وجه من شاؤوا، لابتزازهم أو استجابة لأوامر مستجدة غير معروفة.
وهكذا عاشت سوريا حالة من التناوب غير المنتظم بين القانون واللا قانون وقع تحت وطأتها الجميع، وزادت مع ارتفاع الرتبة في مسالك النظام المعقدة والخطرة إلا على رجل واحد منفرد في القمة. وضمن هذه الثنائية يمكن رصد مئات القصص غير المفهومة في التاريخ السوري المعاصر، من إطلاق اليد إلى درجة مفرطة وحتى المساءلة، دون أن يعني هذا تفسير هذه الحالات، بسبب غياب المعطيات من تقارير مخابراتية، وشبكة العلاقات والولاءات المتشعبة، وحسابات الأسد.
غير أن خطوطاً ثلاثة اتبعها النظام مؤخراً ربما تلقي ضوءاً مفيداً على ما يجري. وهي مسارات قد تكون متكاملة وإن بدت متنافرة. وأعني وصول إشعارات بوفاة معتقلين إلى أمانات سجلاتهم المدنية؛ و«العفو» عمن تبقى من أبريائهم؛ ومحاسبة بعض من اشتهر بالتشبيح وارتكب انتهاكات تجاوزت كل حد وأمكن استضعافه والقدرة عليه. تتكامل هذه المسارب في أنها تؤدي، في النظر العليل للنظام، إلى طي «صفحة الحرب» واستعادة صورة الدولة بعدما أمعن في الجنوح أثناءها إلى خيار العصابة. فكل حرب تقوم على وجود «شهداء»، وها هو يعيّن ذويهم في الوظائف الحكومية المتوافرة؛ وإلى «مجرمين»، وقد تم إعدامهم كما تؤشر القوائم الواردة إلى «النفوس»؛ وإلى عائدين إلى المجتمع بعد التغرير بهم، وقد تم العفو عنهم؛ وإلى أفراد أو فئات صغيرة من قوات النظام ارتكبت «تجاوزات» قانونية هنا أو هناك، مستغلين انشغاله بالتصدي المحموم للحرب الكونية.
وكما تم فرز مئات آلاف السوريين إلى إحدى الفئات السابقة، بالمصادفة أو لعوامل شتى غير منتظمة؛ يبدو أن الحظ السيئ أوقع أمجد يوسف في شر أعماله بعدما نشرتها صحيفة الغارديان، وربما يصنف في خانة «ضعاف النفوس» الذين استغلوا ثقة القيادة وخانوا مسؤولية «البدلة العسكرية»، التي لم تكن يوماً من الأعوام الأحد عشر الفائتة إلا مضرجة بدماء مواطنيها، بشكل عام ومنهجي.
———————–
==========================
تحديث 26 أيار 2022
————————–
في النقاش السوري عن المجازر والطائفية/ عمار ديوب
لا يخفُت النقاش بشان الطائفية في سورية حتى يعود؛ أيّة أحداثٍ أو تطورات جديدة تعيده، وفعلت ذلك مجزرة التضامن “الطائفية”، قبل أسابيع. وتفعل الشيء ذاته مداخلات سوريين كثر على وسائل التواصل الاجتماعي؛ علمانيين كانوا أو طائفيين، أو سواهما .. وهذا يعني أن المسألة الطائفية قضية حقيقية، وليست مرتبطةً بتلك المجزرة، ولا بطائفيين يتبنّونها أو بسياسات السلطة أو بتنظيمات سلفية أو جهادية، فكيف نفسّرها هذه الطائفية؟ تريدها السلطة من أجل غايات وظيفية بامتياز، وتبتغي تكريس الوعي الطائفي، بقصد ديمومة السلطة، وتأليب الطوائف الدينية على بعضها بعضاً في سورية؛ السلفيون والجهاديون والطائفيون عامة، يجدون فيها مرجعيتهم وحاضرهم ومستقبلهم.
دفعت المجزرة بعض المثقفين السوريين إلى البحث في تاريخ المجازر بين العلويين والسنة، وضرورة تفكيك ذلك، من أجل توضيح أهوالها، ودورها في تأبيد السلطات “الدينية”، ودفعت آخرين إلى تطييف تاريخ سورية بأكمله، ليصير التاريخ السوري، ومنذ مجيء الاحتلال الفرنسي وجلائه، طائفياً بامتياز، تتبادله “النخب السنية” ثم تسيطر عليه “النخبة العلوية” بعد 1963. يرى آخرون سورية طوائف، أغلبية وأقليات، وكل الحركات السياسية في تاريخ سورية لا تتعدّى أن تكون دفاعاً غير مباشر عن هذه الطائفة أو تلك، أي يرون الشعب السوري هو هو في الحاضر وفي الماضي، أغلبية وأقليات، وما زال على حاله. من دون شك، هناك نظريات كثيرة، أغلبها مستورد لتفسير أزمات المجتمع السوري وتعقيداته، وطبعاً ليس من مشكلةٍ في ذلك الاستيراد، المشكلة في نقل الأفكار ذاتها وتطبيقها على الوضع السوري. ولا ترى هذه المقالة في الممارسات “الطائفية” الاجتماعية مُشكلة، فهي من بقايا الوعي التقليدي “التاريخي”، وليست أيديولوجيا وأحزابا سياسية طامحة للسلطة.
التوظيف السياسي الشديد للطائفية بعد 2011، من السلطة أولاً، ثم من جماعاتٍ سياسيةٍ سورية معارضة؛ الإخوان المسلمين خصوصا، ساهم بتكريس الطائفية، شكلاً سياسيّاً للصراع السوري، بينما كانت الثورة واعيةً لضرورة تجنّب الطائفية، كما في الثمانينيات، وإن لم تتبن رؤىً فكرية وسياسية دقيقة رافضةً للمسألة الطائفية، وتفكّك أشكال وجوهها الفعلية في سورية، تاريخاً وثقافة وممارسات سياسية وقوى سياسية، وكذلك أشكالها في ممارسات السلطة، والمهام الوظيفية من وراء ذلك.
هناك عاملٌ طائفيٌّ شديد الوضوح في المجازر التي ارتُكِبت في سورية منذ 2011، ومن كلّ الأطراف، حتى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مجازره ضد السنة كان طائفيّاً؛ وهناك مجزرة عدرا العمالية في 2013، وكذلك المجازر التي ارتكبتها مليشيات طائفية تابعة لبعض الأجهزة الأمنية في حمص وبانياس هي طائفية، وسواها كثير، وكان القصد منها اجتثاث الآخر، واستغلالها من ديمومة السلطة الراهنة، أو الوصول إلى السلطة من السلفيين والجهاديين .. مرتكبو تلك المجازر، ومن كلّ الأطراف، طائفيون بالضرورة، لكنّهم شخصيات بسيطة وهامشية، بينما المسؤولية الفعلية تتحمّلها الجهات السياسية والأمنية التي تقف خلفها، سورية وسواها.
ليست الطوائف، بأكثريتها أو أقلياتها، مصدر السياسة في سورية قبل الاستقلال وبعده، وليست مرجعية الصراع السياسي في هذه الأزمنة. هي تشكيلات أهلية، وبيئة اجتماعية للأفراد، وما زالت موجودة، وتميل دراساتٌ كثيرة إلى أنها مستمرّة. وعدا ذلك، تُخفّض هذه النظرة من دور العشائر كعلاقات اجتماعية وثقافية، بل وسياسية أيضاً، وهي أيضاً منتشرة، وبقوة في سورية. يتجلى الوعي الديني قيماً أخلاقية في الممارسات السياسية. أما الوعي الطائفي في الصراع السياسي فهو حديث العهد، ففي الخمسينيات تأسّس مع تأسس الإخوان المسلمين، أي لم تكن الطبقة الحاكمة طائفية، وقد كان الحزبان، البعث والشيوعي، خصوصاً، محمولين على قضايا اجتماعية ووطنية وقومية وأممية، وحتى التطورات اللاحقة في سورية لم تتخذ من هذه القضايا مرجعيةً وسياسات من أجل تحقيق مشروع طائفي، للعلويين مثلاً. يتجاهل النقاش الطائفي بالكامل كلّ التطورات الاقتصادية والسياسية حينها، كالتأميم والإصلاح الزراعي والتوسع الاشتراكي فكراً وسياسةً، والخلاف مع دول الخليج وقتها، وحتى الخلاف مع الاتحاد السوفييتي قبل تسلم الجنرال حافظ الاسد السلطة بشكل كامل في 1970؛ والصراع السياسي بين كتل “البعث” وسواها كان على السلطة وصراع برامج سياسية. وضمن ذلك، ستَستخدم كلّ الأطراف كلّ الإمكانات للتغلب على الطرف الآخر، ولا سيما اتجاه حافظ الأسد حينها، وشخصيات كثيرة فاعلة حينها في اتجاهه لم تكن علوية، وحتى العلوية منها كانت في صفّه من أجل وصولها هي السلطة، وليس من أجل إيصال الطائفة العلوية إليها؛ الكتل “العسكرية” الأخرى، أيضاً لم تكن سنّية خالصة أو درزية أو مسيحية.
محدودية قوة الإسلام السياسي في سورية مرتبطة تاريخياً بصعود الفكرة القومية منذ بدايات القرن العشرين وطرد الاحتلالات، ورغبة السوريين عامة في البحث عن مشتركاتٍ وهوية سياسية جديدة، ولا يشكل بروز “البعث” قوّةً بارزة في الخمسينيات إلّا اتكاءً على ذلك الصعود، ومعاقبة مجتمعية للنخبة الحاكمة التي أرادت بناء سلطة ودولة لتأبيد حكمها ومصالحها، وكذلك لمعاقبة الشيوعيين حينها على انسياقهم خلف سياسة الاتحاد السوفييتي في الاعتراف بإسرائيل. وكان الإسلاميون مشغولين بالوصول إلى السلطة وأسلمة المجتمع ورفض العلمانية والقومية. وبالطبع، لم يتلمّسوا حاجات المجتمع في الإصلاح الزراعي والتعليم العام ومسألة فلسطين بوصفها قضية قومية. لا يمكن قراءة تلك التطورات من زاوية استبدال النظام “السني” بـ”نظام علوي”، هذا تفكيرٌ سطحيٌّ للغاية.
لقد هَمّشت التطورات العامة في سورية الإسلام السياسي، والذي وُلِدَ في منتصف الاربعينيات في سورية. والتطورات ذاتها رفعت من دور الجيش المنظم ليقوم بالتغيير لصالح القضايا الاجتماعية أو الوطنية أو القومية. لم يكن حافظ الأسد إلّا ديكتاتوراً، كحال بقية القادة العسكريين الذين وصلوا إلى السلطة في العالم الثالث، وأراد جعلها له ولعائلته أولاً، كما حال بقية القادة (ربما يخرج جمال عبد الناصر عن ذلك). وفي سبيل ذلك، أعاد المجتمع إلى بنيته الأهلية ولتأبيد سيطرته. ضمن ذلك، سيَستخدم كل الوسائل من أجل ذلك، أي سيستخدم القمع والفساد والإفساد، والتطييف المحدود، وكذلك سيستغل العلاقات الأهلية التي ينتمي إليها، وهذه ليست ممارسةً طائفية، أو القول إنها علوية سياسية، أو نخبة علوية سلطوية، بل هي “أهلية” ولصالح تأبيد السلطة الشمولية والحكم الفردي.
فَرضت السلطة، منذ السبعينيات، أشكال استغلالها ونهبت ثروة الدولة، وهمّشت قطاعاتٍ واسعة من التجار أو الصناعيين، ومارست القمع عاملاً أساسياً لخنق الحريات واجتثاث السياسة. واجه المجتمع السلطة وجبهتها الوطنية التقدمية حينها بحركات يسارية جديدة وقويت شوكة الإخوان المسلمين أكثر فأكثر، وقَمعت السلطة هذه الحركات بعنفٍ شديدٍ، وكانت حرب اجتثاث للإخوان، والانفتاح أكثر فأكثر على مرجعيات سنية أخرى (الشيخ محمد سعيد البوطي مثالاً)، واستمرّت بإعادة المجتمع إلى أهليته، وضمن التسعينيات. ولاحقاً، ظهرت حركات جهادية وسلفية تأثراً بحرب العراق، وأفغانستان، وصراعات “جهادية” كثيرة؛ لكنّها ظلّت حركات هامشية، بفعل القمع أولاً، وبفعل أنّها حركاتٌ “نخبوية” وليست مرغوبة مجتمعياً.
مع الثورة السورية 2011، كانت علاقات المجتمع السوري أهلية بامتياز، أي أن الوعي الديني هو المسيطر. ولم تكن “طائفيته” سياسية؛ وهذا مرتبط بأزمات السلطة وسياساتها في إعادة إنتاج المجتمع الأهلي “الديني”؛ تفسير طبيعة الوعي هذه بأنها امتداد تاريخي قديم غير سليم، وأيضاً ليس من الصحيح تفسيره بدور الاستعمار في إبقاء البنى الأهلية أهلية، ومحاربة البنى الحداثية، أو تسييسها طائفياً؛ للاستعمار دورٌ آخر، ويتحدّد بتشكيل دولنا، دولاً تابعة، وإرساء التجزئة، وزراعة الكيان الصهيوني، ومحاربة أيّ مشاريع سياسية قد تفضي إلى مشاريعٍ وحدوية أو نهضوية جادّة.
الثورة السورية كانت جزءاً من ثوراتٍ عربية، وتَحرّكَ السوريون ضمن هذا الأفق. ولهذا لم تكن الطائفية من أهدافهم، رغم تدينهم الكبير، ولا الانتقام من الثمانينيات، ولا الإتيان بالإخوان المسلمين أو السلفية إلى السلطة؛ لا، ورفعوا شعارات ضد ذلك. وفي الأصل، لم يكونوا طائفيين. وبالطبع، هناك تيارات سلفية وطائفية، لكنها هامشية، لأسباب ذكرت أعلاه. كانت اللحظة هذه مخيفة للسلطة، و”مثالية” للإخوان المسلمين خصوصا، ولأنّها مخيفة، وتَرى بأم العين سقوط الأنظمة في تونس ومصر وليبيا، كان عليها أن تستخدم كل الوسائل، ومنها المجازر، من أجل ديمومة السلطة. تتعلق القضية إذاً بديمومة السلطة ولا شيء أخر، وهي كذلك بالنسبة للمعارضة، ولا سيما الإخوان.
كان الاعتقال والقمع والقتل والمجازر سياسة عامة للسلطة. وككل سلطة شمولية، لا يمكن إلّا أن تفعل غير ذلك؛ هي طبيعة فيها إذن. في سورية كان ذلك، ووظفت الطائفية من أجل إيقاف الثورة الشعبية. واستدعى النظام الخارج والمليشيات الطائفية من إيران والتابعين لها للغاية، ولاحقاً روسيا لتأبيد السلطة. فعلت الشيء ذاته قوى الإسلام السياسي، والسلفية والجهادية لم تتأخرا عن فعل الاعتقال والقمع والمجازر، حينما أصبحت سلطةً في الغوطة الشرقة وفي الرقة ودير الزور وأرياف حلب وفي إدلب وفي مناطق سيطرتها.
ولا يمكن طي صفحة المجازر والاعتقال والقمع بالنقاش السياسي غير الجاد، أو بتحويل تاريخ السوريين إلى صراعات طائفية بل عبر القضاء. وحينما يحصل التحوّل السياسي، ويتقدّم القضاء بدراسة هذه الملفات، ووضع المسؤولين عنها في السجون؛ وترافق ذلك مبادرات شعبية وثقافية وسياسية، تسعى من أجل إرساء السلم الأهلي.
والنقاش في الطائفية لن يتوقف أبداً، فهو يتعلق بالسياسة وليس بوجود الطوائف، والمناخ مؤاتٍ بشدّة لذلك، فهناك هزيمة الثورة، غياب الهوية المشتركة للسوريين، وعوامل كثيرة. الطائفية السياسية تستقي قوتها من غياب الديمقراطية والحريات والنظام الممثل للكل الاجتماعي والظلم “الطائفي”. حينما يتحقق النظام الممِثل للكل يمكن أن يخفت ذلك النقاش، أو لنقل سيتخذ أشكالاً أقلّ حدّة.
إزالة الغبن عن الطوائف بتنوعاتها تتحقق بالتحوّل الديمقراطي للسلطة وللمجتمع، وبصعودٍ جديدٍ وفاعل للمشروع الوطني، وهذا ما ركز عليه برهان غليون في كتابه القديم “المسالة الطائفية ومشكلة الأقليات” الكتاب المُستعاد بقوّة هذه الأيام.
العربي الجديد
—————————-
===================
تحديث 29 أيار 2022
——————–
أوجه المجزرة السبع/ ياسين الحاج صالح
هل يمكن الكتابة عن مجزرة التضامن بهدوء، أقلّه بمثل هدوء بطلها أمجد يوسف وهو يقتل أناساً لا يعرفهم؟ يعتقلهم لكي يقتلهم؟ يمكن ويجب. المجزرة تطلب منا الكلام بشأنها، ألّا تُنسى، وألّا تَغرق في هياج عاصف لا يلبث أن يخمد، مخلفاً وراءه المرارة والسينيكية. كرامة الضحايا لا تُصان بكلام زاعق، والكتابة ليست مجالاً للانفعالات الهائجة، لمجازر بحق الكلمات لطالما سارت يداً بيد مع المجازر ضد البشر. في مواجهة المجزرة، نستجمع كل ما يتاح من حسّ بالكرامة الإنسانية كي لا تكون الكتابة استئنافاً لجنون القتل الذي يتعذر على من يشاهده إلا يُمَسّ به.
تثير المجزرة التي ارتكبت يوم 16 نيسان (أبريل) 2013، وأُتيحت معلومات مفصلّة عنها بعد تسع سنوات من ارتكابها، مجموعةً من القضايا ننظر عن قرب هنا في سبعة منها. تتصل أولى القضايا بتوثيق المجازر والكشف عنها، ماذا نعرف وماذا لا نعرف؟ وثانيتها، ما يتصل بالطائفية والثأر وضرورة العدالة. والثالثة بما تقوله لنا المجزرة عن نمط ممارسة السلطة في سورية. والرابعة ما يتعلق بالصور والفيديوهات، وما إذا كان لنا أن نراها ونريد أن تُرى من غيرنا في سورية والعالم، أم العكس. والقضية الخامسة تتصل بوصف وتمييز الشرّ الذي شهدناه في الفيديو، وربما شهده معنا ملايين الناس. والقضية السادسة تتصل بما يمكن قوله، تأسيساً على المجزرة، عن تكوينٍ إباديّ للحكم الأسدي، والقضية السابعة والأخيرة تتطرق إلى الاقتصاد السياسي للحكم بالمجازر.
أنوِّه إلى أن هذه المناقشة مبنية على ما نُشرَ من معلومات بخصوص المجزرة في كل من صحيفة الغارديان البريطانية والجمهورية
يوم 27 نيسان (أبريل) 2022، وعلى ندوة عبر زوم نظمتها الجمهورية مساء 11 أيار (مايو) 2022.
ماذا نعرف وماذا لا نعرف؟
ليس الجديد بخصوص مجزرة التضامن وعموم المجازر في سورية معرفة وقوعها، أو عدد ضحاياها، أو مآل أجسادهم وأجسادهنّ المقتولة. فقد جرى تداول أخبار كهذه طوال الوقت منذ بدء الثورة السورية تقريباً. لكنها كانت أخباراً عائمة وغائمة، إمّا غير موثقة بقدر كاف، أو أن توثيقها لم يُتَح لاطّلاعٍ واسعٍ بين السوريين وغيرهم، أو هي معروفة ضمن دوائر محلية محدودة. معرفةُ أن مجزرةً وقعت شيء، ومعرفة المجزرة، أي الإجابة على أسئلة ماذا ومن ومتى وأين وكيف، شيءٌ آخر. الافتقار إلى توثيق مفصّل بشأن عشرات المجازر يفتح باب التنصّل من المسؤولية عنها، أو التقليل من شأن ما جرى فيها، أو التشكّك بحدوثها ذاته. هذا غير ممكن بخصوص مجزرة التضامن. صورة المجزرة كما صرنا نعرفها منذ شهر مرسومة بالألوان إن جاز التعبير، غنية بتفاصيل عن الزمان والمكان والفاعلين والإطار الذي وقعت ضمنه. خلال 11 عاماً لا نملك نموذجاً مماثلاً. وحتى حين كان ثمة تغطية معقولة لبعض المجازر، مجزرة الحولة (أيار 2012) التي حققت فيها الأمم المتحدة مثلاً، فإنه لم تُتَح إلى اليوم فيديوهات تُمكِّنُ من معرفة صور المرتكبين المباشرين وأسمائهم. وحيث أُتيحت فيديوهات لعمليات قتل، فإن تحديد القتلة بالأسماء والمواقع الوظيفية يحتاج إلى جهد كبير، مثلما نعلم بخصوص جريمة التضامن وبطلها أمجد يوسف. لزمَ عامان من التحرّي عنه ومتابعته حتى انكشفت الحقيقة، أي حتى نطق الشرط المُصوَّر بما لا يقوله بحد ذاته. كان هذا جهداً بطولياً من الباحثة أنصار شحود، أنهكها نفسياً وروحياً، على ما أشار تقرير الغارديان. مثلُ هذا قد لا يُتاح بخصوص معظم المجازر. فنحن لا نتحدث بخصوص مجزرة التضامن عن فريق تحقيق مختص، بتفويض دولي وتمويل وافٍ، بل عن «عملية فدائية» نادرة. ورغم ذلك، نعرف الآن أن معلومات وأسماء عن بعض الضحايا، وعن الجناة، صارت معروفة بصورة أفضل بعد أن رُويت القصة، ونُشر تقرير الباحثيْن، أور أونغر وأنصار شحود بالعربية والانكليزية. مصدر المعلومات والتفاصيل الإضافية هو أهالٍ من منطقة التضامن أو جوارها (مخيم اليرموك بخاصة)، أو متابعين لمجازر النظام المتنقّلة في المناطق حول دمشق.
هناك شرط سياسي معلوم لتواضع التوقعات بإحاطات مفصلّة بخصوص مجازر أخرى: النظام الأسدي لم يُقلب وتُكشَف أسراره ويُحاكم أركانه مثلما جرى للحكم النازي في ألمانيا، وفُرص الإيقاع بقتلة آخرين بالطريقة نفسها أو ما يقاربها تبقى محدودة جداً، ولو لأن القتلة يتعلمون من انكشاف بعضهم. الشرط الجذري لمعرفة الحقيقة هو سقوط الحكم الأسدي، والدولة الباطنة بخاصة، أي الأسرة الأسدية وجملة الأجهزة المعنية بالوظيفة الأمنية، وذلك لكونها المنظمة المسلّحة الأكثر سرية وفئوية وعنفاً في سورية، أي نقيض الدولة وضدها. والأرجح أن رواية الحقيقية الكاملة ستأخذ سنوات وعقوداً حتى بعد أن يقلب النظام، فالأمر يتعلق بأزيد من نصف قرن من الجريمة المنظمة. الفيلم السوري الطويل لا يزال أمامنا.
المجزرة والطائفية
هل يمكن الاعتراض على منطق الثأر الذي مارسه أمجد يوسف، ويدعو إليه أشباهٌ له ضد العلويين، دون التعامي عن البعد الطائفي في الجريمة؟ يمكن ويجب هنا أيضاً. ليس لأمجد يوسف، وهو مساعد في جهاز الأمن العسكري، أي حق في الثأر. هذا لأنه يعمل فيما يفترض أنها مؤسسة دولة، عاملة على إنفاذ القانون، والثأر نفيٌ للقانون والدولة معاً. نعلم أن الدولة الأسدية ليست مؤسسة حكم عامة ولم تكن كذلك قط، وأنها في الواقع دولة ضد الدولة (ومن هذا الباب «ضد الأمة» كذلك، بتعبير الدكتور برهان غليون). أجهزة أمن النظام مُطيَّفة جداً، ينتشر فيها مزيجٌ سرديٌ معقد من التفوق والحصانة والتهديد والخطر الوجودي، وتُشكّل بيئةً ثأريةً نشطةً باستمرار يزدهر فيها أمثال أمجد يوسف. نتكلم على نظام طائفي لأن الأمر يتعلق بحكم متمركز حول الوظيفة الأمنية التي يعتمد عليها في إعادة إنتاج نفسه وضمان دوامه، ولأن هذه الوظيفة مُطيَّفة تكوينياً، أي منذ البداية وطوال الوقت، ولها تاريخ في القسوة الوحشية والتمييز. الجريمة بالتالي ليست جريمة شخصية، بل هي جريمة بنيوية، تنبع من تكون النظام وأجهزته الأمنية. وإنما لذلك لا يجدي في مواجهتها الشحن الطائفي وطلب الثأر. ما يفعله الثأر الطائفي المضاد، على افتراض إمكانِ الأخذ به، هو إحلال قتلة محل قتلة ومقتولين محل مقتولين، وبالتالي تسويغٌ بمفعول راجع لمجزرة التضامن ذاتها. الثأر الطائفي يضفي النسبية على الجريمة التي أطلقت المسلسل الثأري، لتصير جريمةً مثل غيرها في سلسلة مفتوحة من جرائم، يبرر بعضها بعضها الآخر. والواقع أنه وقعت سلفاً مجازر طائفية، كان أبطالها طائفيون سنّيون في مناطق من شمال اللاذقية وفي عدرا العمالية وغيرها، وبرَّرت نفسها بمنطق الثأر. أتاح ذلك لكثيرين القول: المجزرة بالمجزرة والجريمة بالجريمة، وإذا كان النظام مجرماً فإن معارضيه مجرمون كذلك. وهو ما تواترَ قوله بالفعل بعد انكشاف مجزرة التضامن، وسبق أن قيل مثله كلما وقعت أو انكشفت جريمة كبيرة. وليس رداً مقنعاً على ذلك بأن جرائم المعارضة أقل بكثير من جرائم النظام، وتكاد تكون بنسبة ضحايا أمجد يوسف الـ41 (ويبدو أنه ومجموعته ضالعون في مقتل 288 توفرت للباحثيْن الفيديوهات عن مقتلهم)، مقابل فرد واحد هو أخوه نعيم الذي قتل في معركة داريا. ليس رداً مقنعاً لأن المسألة ليست في أنه كان يجب أن يقتل النظام أقل، أو يقتل الثائرون عليه أكثر، بل في أن اعتماد القتل كسياسة مفتوحٌ فقط على الإبادة. نعيم يوسف، بالمناسبة، قتل وهو يحارب مقاومين محليين يدافعون عن بلدتهم التي كانت، قبل شهور من مقتله في الشهر الأول من 2013، قد شهدت مجزرة سقط فيها ما لا يقل عن خمسمائة من أبنائها في آب (أغسطس) 2012.
الثأر يُطيِّف، تتشكل حوله جماعات ناقمة وثأرية. والطوائف ذاتها (والعشائر كذلك) تتشكل بالثأر، ولا تدفع إلا باتجاه الثأر. ومثل الطوائف والعشائر، الدولة الأسدية الباطنة التي هي منظمة ما دون دولة، سرّية وفئوية وعنيفة مثلما تَقدَّمَ القول، تحتل الدولة العامة التي انقلبت طوال عقود إلى قناع مؤسسيّ لها. والفاعلية العامة لهذه الدولة الباطنة خلال نصف قرن هي تقدم التطييف العام عبر التمييز والمعاملة العدائية والعنيفة للمحكومين. نحن لا نولد علويين أو سنيين أو غير ذلك سياسياً، وإنما نصير كذلك. هذا أساسي في أي نظرية عن الطائفية، مثلما هو أساسي في النسوية ونظرية الجندر (وهو يحاكي قولاً شهيراً لسيمون دو بوفوار عن النساء). والعلاقة بين الاثنين، الطائفية والجندر، ليست خارجية ولا عارضة فيما يبدو. تقرير الباحثين يكشف عن استغلال جنسي وعبودية جنسية من قبل المخابرات والشبيحة بحق نساء المنطقة، بدلالة هويتهن الأهلية، بصورة لا تختلف في شيء عن استغلال داعش الجنسي واستعباد الدواعش الجنسي لنساء إيزيديات. أمجد يوسف شخصياً بطلُ استعبادٍ جنسي لنساء، بقدر ما هو بطل قتلٍ لرجال.
نصير سنيين وعلويين وغير ذلك عبر عمليات صانعة للطوائف وصانعة لنا كطائفيين، منها ممارسات سياسية تمييزية، ومنها جَنسنة الجماعات الأخرى واستحلالُ نسائها، ومنها اعتبار جماعاتنا الأهلية أُطُراً للعدالة، وهذا هو معنى الثأر، ومنها بخاصة المجازر. رأينا منذ وقت مبكر من عام 2012 مسلسل مجازر طائفية بدأ في شباط (فبراير) 2012 بكرم الزيتون، وتنقَّلَ في مناطق حمص ودمشق وطرطوس وحماة، ومنها الحولة والتريمسة والقبير وداريا وجديدة عرطوز وبانياس والبيضا وغيرها، مجازر قَدَّرت أنصار شحود ضحاياها في المنطقة حول التضامن وحدها بما بين 30 و50 ألفاً؟ هل كان ذلك بهدف خلق أوضاع ثأرية وتغذية التطرف؟ أياً يكن، نَصيرُ علويين أو سنيين أو غير ذلك عبر عمليات صنع الطوائف هذه. الطائفية هي بالضبط صنع الطوائف كوحدات سياسية من مواد أهلية أقل تمايزاً وأقل سياسية. أمجد يوسف نتاج تطييف اجتماعي وسياسي، لا ينبع حتماً من واقعة ميلاده لأبوين علويين، ما دمنا نجد ترجمات مختلفة ومتناقضة لوقائع الميلاد. الشاب الذي سرَّبَ الفيديوهات من منبت علوي، ما يعني أنه قاومَ أن تتحكم به مصادفةُ الميلاد التي لا يدَ له فيها.
ولذلك يُخطئ منطق الثأر الطائفي لأنه يتجه نحو الميلاد، الهوية الموروثة، وليس نحو عمليات التطييف وديناميكياته.
هذا يطرح سؤالاً عن الجريمة التي أطلقت المسلسل الثأري؟ ما هي نقطة البداية التي لا يمكن إضفاء النسبية عليها؟ أرى أنها تطييف الوظيفة الأمنية التي هي جوهر الحكم الأسدي، وهذا لأنها ليست حدثاً، بل بنية مستمرة طوال نصف قرن، وتُشكِّلُ الإطار الدائم للتطييف وإعادة إنتاج الطوائف. يجري إنكار هذه البنية علانية طوال الوقت، وتأكيدها ضمناً في الوقت نفسه: حين يبرر موالون للنظام مجزرة التضامن أو غيرها بمجازر ارتكبها معارضون، يظهرون فقط أنه يفكرون في النظام كطرف فئوي خاص، بالضبط كطائفة، لا كدولة عامة. ولذلك فإن تغيير البنية هو وحده ما يمكن أن يقطع سلسلة الثأر، ويؤسس للانتقال من منطق الثأر والطائفة إلى منطق العدالة والدولة، فلا نسوغ جريمة لاحقة بجريمة سابقة.
الدفاع عن عدالةٍ سوريّةٍ عامة ممتنعٌ دون تغيير سياسي أساسي، لأن «الدولة» هي المجرم العام، الذي استهدف المدنيين بصورة منهجية طوال سنوات الصراع، وأفرد قطاعاً أهلياً من محكوميه بالمجازر الطائفية والبراميل المتفجرة والاستهداف بالغازات السامة. قد لا يكون ذلك مستطاعاً اليوم أو في أي وقت قريب، لكن تبّني منطق التحريض والثأر الطائفي يُبعدنا عنه أكثر ولا يقربنا منه.
الحكم اليدوي
قُتِلَ ضحايا التضامن عن قرب شديد، أُوقعوا في حفرة، وأُطلقت عليهم النار من مسافة تتراوح بين متر وخمسة أمتار، باستثناء رجل مسن قتله أمجد يوسف ذبحاً بحسب تقرير الباحثيْن، أي بالتماسّ المباشر. ثم قتل الجميع مرة ثانية بعد قتلهم الأول بأن أُحرقت أجسامهم المقتولة للتو مع عشرات من دواليب السيارات المهيئة سلفاً. الضحايا مدنيون، يبدو أنهم أُوقفوا لتوهم، قُيدت أيديهم خلف ظهورهم وطُمّشت عيونهم وسيقوا فيما يبدو إلى مكان قريب من الحفرة التي حفرها لهم أمجد يوسف نفسه بجرافة قادها بنفسه، وهناك قُتلوا وأُحرقت أجسادهم المقتولة، وطمرت بالجرافة نفسها التي قادها أمجد يوسف بنفسه. صارت الحفرة قبرهم الجماعي. ظاهرٌ أن هناك نية مسبقة وتخطيطاً واستجماعاً لأدوات المجزرة. نية تبحث عن مقتولين، وتعثر عليهم بيسر على واحد أو أكثر من 60 حاجزاً مسلحاً نصبها النظام في حي التضامن الذي قُسِّم إلى 13 قطاعاً، فاستحق بذلك لقب «مثلث برمودا» بحسب التقرير. المطلوب مدنيون يُقتلون بسهولة. ولا يبدو أنه حُقِّقَ معهم، ما يعني أنه لم يكن مهماً ما فعلوا أو لم يفعلوا، ولا العمر ولا الجنس ولا الجنسية الأصلية (يبدو أن بين الواحد وأربعين ضحية ثلاثة فلسطينيين على الأقل). ما بدا أنه يهم القاتل الطائفي هو تطييف الضحايا على نحو يجعلهم أعداء، مباحين للقتل.
عموماً يتسم القتل الثأري بأنه قتل عن قرب، بحيث تتماس أجساد القتلة والمقتولين، ربما لأن هذا القتل ممتزج هنا بالكره الذي ينتقل بالقرب أو التماس. ثم لأن التمتع بمعاناة الضحايا تقتضي القرب. في تقريرهما المنشور في الجمهورية، يقول الباحثان اللذان اطلعا على جميع الفيديوهات المهربة: «كما مارس جناة الحرب، بمن فيهم أمجد يوسف ونجيب الحلبي، تعذيباً قاسياً وتجريبياً بغرض الاستمتاع بمعاناة الضحايا». وفي موقع آخر يقولان إنهما لمحا «درجة من الاستمتاع» عند القتلة بعمليات القتل.
القتل عن قرب في «سورية الأسد» مكتوبٌ في نمط الحكم عن قرب، أو الحكم اليدوي إن جاز التعبير، على نحو يكثفه التعذيب أكثر من غيره. التعذيب هو العلاقة السياسية الأساسية في سورية الأسد، وهو يقتضي القرب الشديد، فلا تتوسط بين الجلاد وضحيته غير عصا أو «كبل» أو أدوات تدار يدوياً. والتعذيب بطبيعة الحال مشحون بالكره والانفعالات العدائية. ولِتَخلُّلِ المجتمعِ بالمخبرين وتشجيع الوشاية، والاعتقال السياسي المزدهر منذ بدايات الحكم الأسدي، وتقييد الحصول على جوازات السفر، دلالةُ التعذيب ذاتها على الحكم اليدوي. وخلال خمسين عاماً ونيّف، تمخَّضَ ذلك عن سورية صغيرة وضيقة، مثل حفرة أمجد يوسف.
ولعلنا نفهم تطميش عيون الضحايا وتقييد الأيدي إن فكرنا فيهما كإنتاج أناس مسلوبي الإرادة من الرعب، مشلولين نفسياً، معدين للقتل، فقدوا القدرة على التوجه والتحكم بحركة أجسادهم، فلا يستطيعون الهرب ولا المقاومة. تلزم منهم الآذان كي يسمعوا الأوامر والإهانات (الرجل عرص والمرأة شرموطة)، والأقدام كي يتحركوا في العماء نحو حفرتهم الأخيرة. هذا نموذج للحكم الأسدي: أن يَرى الناس ولا يروه، أن يكونوا مكشوفين له تماماً، عراة، بينما يكون هو سراً مكتوماً عنهم، يرتدي ألف حجاب وحجاب، وأن يعزز بالسلاح يديه بينما تقيد أيديهم. الحكم عن قرب هو أن يكون المحكومون عزّلاً، عمياناً، مشلولين، وتحت عيون الحاكمين المسلحين.
ويتنافى القرب الشديد مع اتجاه التطور السياسي والعسكري المميز للحداثة، وهو تطور باتجاه البعد، بما في ذلك الحكم عن بعد، أو بالمؤسسات، في «المجتمع الانضباطي» الذي اقترن بزوال التعذيب مثلما نعلم، وبما فيه القتل عن بعد في الحروب.
سارت سورية نسقياً باتجاه البدائية السياسية مع رَوْتنة التعذيب ومع تطييف أجهزة التعذيب في وقت مبكر من حكم حافظ الأسد، ثم مع النزع المتفاقم لبيروقراطية الدولة لمصلحة الشخصنة والمحسوبية. وإلى جانب الحكم عن قرب وتعبيراً عنه، أخذنا نشهد سيلان العنف في الحياة اليومية، وهو عكس مسار العملية التحضيرية التي درسها نوربرت إلياس، وتميزت بانسحاب العنف من الحياة اليومية. إهانة مواطنين في الشارع وضربهم، أو حتى قتلهم، ميزت الحكم الأسدي منذ سبعينات القرن الماضي.
وبطبيعة الحال، لا نخرج من نموذج الحكم عن قرب ببدائيته ووحشيته بإحلال قتلة طائفيين محل قتلة طائفيين، أو بإحلال «شفاء الصدور» و«إرواء الغليل»، أي الانتقام الذي يريده طائفيون سنّيون، محل عدالة قضائية تحاسب الناس على أفعال ارتكبوها، وليس على ما يكونون أو على هوياتهم الموروثة.
وقد نتذكر في هذا السياق أن القتل عن قرب كان مُفضَّلاً عند داعش بالتناسب مع انفعالات الدواعش المفعمة بالكراهية ومع مخيلة سياسية قبل حديثة، يجري تَصوُّرُ الحكم فيها كسيطرة مباشرة على أجساد تُضرَب وتُجلَد وتقطع وتصلب وتقتل، وتفضيلياً بالسيف.
المسألة هي أن تُطوى صفحة الحكم اليدوي أو الحكم عن قرب، وليس أن تتغير أيدي الحاكمين والجلادين العاملين بإمرتهم. أي أن تتوسط الحقوق والقوانين والمؤسسات العامة الفاعلة بين الحاكمين والمحكومين، على نحو يخلق مسافة أو بعداً، يحمي الناس ويقصر يد أصحاب السلطة.
هل ننظر؟
القضية الرابعة تتصل بالصورة والفيديوهات، هل تُرى؟ هل نراها؟ هل ينبغي أن تتاح لمن يريد أن يرى؟ جرى نقاش في هذا الشأن قبل سنوات، ودافعَ كاتب هذه السطور عن ضرورة أن نرى، وأن تُتاح الرؤية لمن يريد. الصور، إن وجدت، تدعونا إلى ننظر فيها، أن نرى. وما دام قد وقع ما وقع، فالأفضل أن يُصوَّر لا أن «لا يُصوَّر»، وما دام ثمة صور فالأفضل أن تُتاح لا أن «لا تُتاح»، وأن تُرى لا أن «لا تُرى». على أن نفتح نقاشاً عن معنى ما نرى وماذا نبني عليه من معان وأفكار وقواعد فُضلى. ثم على ألّا نجعل مما قد نستقر عليه من خيارات في شأن الصور عقيدة جامدة أو دوغما معصومة. الصور تمثل واقعاً، ومهما أمكن أن نفكر في ما تثيره من مشكلات، فليس لذلك أن يكون على حساب ما جرى في الواقع: لقد قتل الناس كالحشرات في مجزرة رهيبة. فمن له عيون، فليرَ!
للصور والفيديوهات قيمة لا منافس لها كأدلة في أي عمليات قضائية قد تُطلق يوماً، وقيمة أخلاقية وسياسية مستمرة في غياب العملية القضائية. وأياً تكون أوجه إساءة استخدام الصور والفيديوهات فهي ليست حتمية، ولا تنبع بصورة ضرورية من وجود الصور والفيديوهات ومن نظرنا فيها. يمكن أن نتناقش حول سُبُل الاستخدام والتوظيف، ولا شيء يمنع أن يبقى النقاش مفتوحاً، بحكم تكوينه كتفاعل بين أفكار حول تمثيل الواقع في أوضاع قصوى واستثنائية، يصعب القطع في أفضلية حاسمة لبعضها (الأفكار) على بعض. في كتابها عن الصور، دعت سوزان سونتاغ إلى أن ندع الصور عن الفظائع تسكننا وتقض مضاجعنا، ما دامت تملك هذه الخاصة التي لا تملكها السرديات، وإن ساعدتنا هذه الأخيرة على الفهم. سونتاغ تخشى أن تُضفي الصور طابعاً جمالياً على المعاناة، أو أن تصير المعاناة كليشيهاً مكرورة، وأن تفضي إباحية الصور إلى إفقادها الشحنة الصادمة التي تُرهَن بها الاستجابة الأخلاقية (أحيل إلى فصل عن التعذيب وأخلاقية التصوير، خصصته جوديث بتلر لمناقشة أفكار سونتاغ، في كتابها: Frames of War, When Life is Grievable).
لكن سونتاغ تعول بعد هذا كله على أن تَسكُننا الصور الفظيعة. وقد لا يقتصر ما يمكن أن يعنيه ذلك على أن يكون ما يعتملُ في النفس بفعل الصور محرضاً أخلاقياً على الاحتجاج، لعل من شأنه أكثر من ذلك أن يكون حافزاً على تفكير يتجدد في شؤون السياسة والعنف والحياة والموت والتمثيل، الإنسان.
وليس ما تثيره النصوص مغايراً نوعياً لما تثيره الصور. ما ورد في تقرير الباحثين عن محرقة بدائية تحرق فيها الجثث يديرها أبو علي حكمت، فتخلف رائحة واخزة في المنطقة حولها بفعل اشتغالها اليومي، يستوقف، يمسك بتلابيب القارئ ويدعوه أن يقرأ ويتفكّر ويعي. والكلام على صالح ر، أبو منتجب الملقب «هتلر سورية»، تنويهاً فيما يبدو بقدراته الإبادية، ليس مما يُقرَأ بتعجُّل ليُنسى. النصوص والصور ليست أشياء جامدة، إنها علاقات، شؤون تتعلق بنا، تطلب أن تُقرأ وأن يُنظر إليها، وأن نستولد من القراءة والنظر معان لحياتنا.
في شروطنا المعلومة لا أحد يملك القرار في شأن إتاحة أو عدم إتاحة الصور والفيديوهات الفظيعة. هذا أحد أوجه افتقارنا إلى عامٍّ وطني من أي نوع، وإشغالِ خاصٍّ همجي، الحكم الأسدي، موقعَ العام. انتشار صور الفظيع اضطرارٌ في مثل شروطنا، يُترك القرار في شأنه للأفراد. وكل شيء يتوقف، والحال كذلك، على ما نفعله بهذا الاضطرار كأفراد. تدافع هذه المناقشة على أن ننظر ونرى، إن لم يكن من أجل الاحتجاج والإدانة الأخلاقية، فمن أجل المعنى والذاكرة. ثقافتنا تتكون حول تمثيل تجاربنا، وأهمها اليوم ومنذ 11 عاماً ما يتصل بالاعتقال والتعذيب والاغتصاب والقتل والمجازر والحصار والتغييب. من هذا المنظور، ليته لدينا صور أكثر وفيديوهات أكثر، وليتها تُحفَظ في أرشيف وطني يتاح الاطلاع عليه للباحثين والمشتغلين في الشؤون العامة. هل حقاً لم نكن نريد أن توجد فيديوهات مجزرة التضامن؟ ومنذ أن وجدت الفيديوهات، ثمة من خاطروا بحياتهم كي تتاح كإثبات لواقع، كدليل قضائي، وككشف لمصائر، وهذا مثلما سبقَ أن فعل المُصوِّرُ قيصر. هل كنا لا نريد أن تُرى وتُدرس ويُكتب عنها؟ هل هناك من يريد جاداً ألّا تتوفر صورٌ عن مجازر أخرى؟
لقد حُرم ضحايا التضامن أن يروا مواقع أقدامهم في لحظاتهم الأخيرة. نحن نراها عنهم. هذا أقل حق لهم.
أي شرّ؟
كيف نصف شر أمجد يوسف؟ هل يصلح مفهوم الشر الاعتيادي أو المبتذل لحنه آرنت في وصفه؟ يبدو أن هناك عدم توافق أساسي بين القتل عن قرب والحكم عن قرب وبين الشرّ المبتذل، الذي يتوافق بالمقابل مع الحكم عن بعد، مما أخذ يميز المجتمعات الأوروبية منذ القرن الثامن عشر. أدولف آيخمان الذي طورت آرنت تصورها للشر المبتذل عبر تغطية محاكمته في القدس كان جزءاً من آلة قتل بيروقراطية، محفزاته تتصل بموقعه في هذه الآلة. آيخمان قاتلٌ عن بعد، والقتل الحربي الحديث معظمه قتلٌ عند بعد، على نحو يقلل من الشعور بالمسؤولية والوساوس الأخلاقية، مثلما أظهر زغمونت باومان في الهولوكوست والحداثة. آيخمان دافع عن نفسه بأنه لم يقتل شخصياً أي يهود، وهذا صحيح. الرجل كان مسؤولاً عن نقل ما لا يحصى من يهود أوروبا إلى معسكرات الاعتقال النازية، التي كانت مصانع موت أنتجت ملايين المقتولين. أمجد يوسف قتلَ شخصياً وعن قرب، وباستمتاع، وأظهر عدائية أكبر في قتل النساء حتى من قتل الرجال (خص إحداهن بخمس رصاصات، بينما اكتفى بواحدة أو اثنتين للرجال)، وقتل أطفالاً، قال إنه يضحي بهم لروح أخيه. هذا ليس شراً اعتيادياً، ليس شرّاً بدون شرير وراءه. هذا شرٌّ شخصي، كاره وثأري، ناقم وإذلالي، يصدر في الوقت نفسه عن حس مترسخ بالحصانة. هذا شر بشرير وراءه.
كيف تَكوَّنَ هذا الشرير؟ أمجد يوسف من مواليد 1986، كانت الأسدية في السلطة منذ 16 عاماً عند ولادته، وأبوه كان رجل أمن قبله، أي أنه ابن النظام، وربيب أجهزته الأشد عنفاً وطائفية. قبل ميلاد أمجد، كانت الأجهزة التي عمل فيها أبوه متمرّسة سلفاً بالاعتقال وفنون التعذيب والقتل، وكان في سجلّها مجازر كبيرة قبل ولادته. رضع أمجد حليب الأسدية المسموم، مزيج التفوق والحصانة والتهديد والخطر الوجودي الذي أشير إليه فوق. بالمقابل، أدولف آيخمان من مواليد 1906، قبل ظهور النازية بنحو 20 عاماً، وقبل وصولها إلى السلطة ب27 عاماً. آيخمان ليس ابن النازية، بل من جيل النازيين الأول. هو أقرب إلى مُنتِج للنازية منه إلى نتاج لها. ولو طال الأمد بالحكم النازي الذي عَمَّرَ بالكاد 12 عاماً لربما ولّدَ أشراره المتمرسين، قتلة تكوّنوا نازياً، ونعموا بحصانة مترسخة مثل حصانة أمجد يوسف. طال الأمد بالمقابل بالأسدية حتى قد يكون معظم جلاديها اليوم من مواليد الحقبة الأسدية، ومن إنتاجها و«منجزاتها»، تربوا على جرائمها التي لم تُعاقَب يوماً.
نظام الذات مختلف بين نموذجي الحكم عن قرب والحكم عن بعد على ما تدل فكرة الثأر ذاتها، وما تحيل إليه من حضور روابط الدم أو القرابة في السلوك، ومن مستوى انفعالات خام، ومن غياب التجرد والانضباط، ومن الاستمتاع بالمعاناة. ليس هناك ما هو عادي في شخصية ومسلك كهذا، خلافاً لما أَوَّلت أنصار شحود ما عاينته في الندوة التي نظمتها الجمهورية مساء 11 أيار 2022. المؤسسة التي يحلو لأمجد يوسف أن يصف نفسه بأنه ابنها هي جهازٌ يجمع بين الاستثناء والعنف والطائفية، وليست بحال مؤسسة عامة تعمل وفق قواعد معلومة مطردة، تتوسط بينها وبين عموم السكان. مفهوم المؤسسة يتعارض مع القرب الذي يطبع عمل المخابرات الأسدية، ويتوافق مع البعد وتوسط القواعد والإجراءات بين العاملين في المؤسسات وعموم السكان. سورية دولة أجهزة وليس مؤسسات بسبب غياب التوسط.
ومع تقدم نزع بيروقراطية الدولة على نحو يتجسد في انعدام شخصية الدولة الظاهرة (الحكومة والإدارات العامة والشرطة وعموم تشكيلات الجيش النظامي…)، تتقدم بالمقابل «شخصنة» السلطة، أي تمركزها حول الشخص وأصله وفصله وروابطه، محلَّ الفرد المواطن الذي ينضبط بقواعد عمل مؤسسية. ومع الشخص يغيب التجرد والقاعدة والروتين، وتحضر النية، والهوى والانفعال، والغرض والكيد، والأخ والأب. أمجد يوسف الذي رأيناه يقتل العشرات بتمكُّن ثأراً لأخيه، لا يجرؤ على التدخين أمام أبيه. هذا غير ممكن التصور في عالم الشر المبتذل.
ودون أن يكون شر أمجد يوسف شرَّ فردٍ سادي منحرف بالضرورة، فإنه ليس شراً مبتذلاً أو اعتيادياً، يتوافق مع البنى البيروقراطية الكبيرة وطاعة السلطة في مجتمعات كبيرة. «السياق الموسَّع لحصانة أجهزة المخابرات السورية والميليشيات الخاضعة لسلطة بشار الأسد المباشرة»، بحسب تقرير الباحثين، يوفر له معرفة كافية بأنه طليق اليد في قتل 288 من «مواطنيه» السوريين والفلسطينيين، وبعلم وإشراف وتشجيع اللواء بسام الحسن، مدير المكتب الأمني والعسكري لبشار الأسد.
المخابرات وقد رُفعت إلى مرتبة القداسة بوصفها «نور السموات» تتوافق مع الإبادة. بوصفها آلة الحكم عن قرب، عملُ المخابرات هو التعذيب والاغتصاب والقتل، هو شغلٌ عنيفٌ مباشر على أجساد الرجال والنساء. مجزرة التضامن الإبادية هي قبسٌ من «نور السماوات»، استجابة لنداء مقدس، هو نفسه النداء الذي أخذ يستجيب له في الفترة نفسها جهاديو داعش والقاعدة وجيش الإسلام. الجرائم الطائفية في عمومها لا تندرج ضمن تصور مُعلْمَن وبيروقراطي للشر. نحن هنا في عالم مختلف تماماً. في تلاقي المقدس والجريمة يجب أن نبحث في الشر الذي عرفناه في سورية، من طرف السلفيين الجهاديين كما من طرف النظام. تَحوُّلُ أمنيي النظام بعد التقاعد إلى مشايخ دين، ومنهم والد أمجد يوسف، ومن مشاهيرهم علي حيدر ومحمد بركات، ظاهرةٌ لافتة، مستحقة لدراسة متأنية.
إبادة؟
وبسؤال الإبادة (الجينوسايد) تتصل القضية السادسة التي تثيرها مجازة التضامن. هل تقول المجزرة جديداً في هذا الشأن؟ الواقع أنه ليس هناك شيء قديم في شأن الإبادة كي نتكلم على جديد، ولم تجر دراسة الحكم الأسدي من هذا المدخل. لذلك لا تتعدى هذه الفقرة اقتراح تصور أول.
وقعت عشرات المذابح قبل مجزرة التضامن وبعدها، منها ما ارتكب بأسلحة الدمار الشامل، ومنها ما حمل التوقيع التدميري الخاص بالنظام، أي البراميل المتفجرة، واصطبغت دون استثناء بصبغة طائفية، هي بالتحديد ما تسوغ الكلام على بنية إبادية أو «جينوسايدية». الجينوسايد، بحسب ميثاق خاص للأمم المتحدة بخصوص «جريمة الجرائم» هذه هو أفعال تستهدف جماعة إثنية أو عرقية أو دينية أو قومية (أي معطاة الهوية سلفاً) بِنيّة تدميرها كلياً أو جزئياً، مثل القتل، الإيذاء الجسدي أو النفسي، التسبب بدمار واسع ينال الجماعة، منع الولادات ضمنها، أو مصادرة أطفالها. ويضمر الميثاق أن الجماعة “ضحية بريئة”، لم تقاوم بالسلاح. وبعبارة مألوفة أكثر في العربية، الجينوسايد هو القتل الجماعي على الهوية أو الإيذاء الجماعي بسبب الهوية.
المفهوم الذي ظهر أثناء الحرب العالمية الثانية، واعتمد في ميثاق خاص للأمم المتحدة عام 1948 بغرض تجريم ومنع هذه الجريمة، كان يحيل ضمناً إلى الهولوكست، إبادة يهود أوروبا على يد النازيين أثناء الحرب. يعاني المفهوم من مشكلات متعددة، منها ما يتصل بما إذا كانت الإبادة مسألة نيات أم وضعيات تاريخية انتقالية وسياقات حربية عنيفة؛ ثم بالهوية المقررة المعطاة سلفاً للجماعة المستهدفة وما إذا لم تكن نتاج عمليات فرز وتمييز، من صنف «تقطيع حي التضامن وتصنيف سكانه»، على ما قالت أنصار شحود في ندوة الجمهورية، أي ما إذا لم تكن الهويات مصنوعة سياسياً؛ وكذلك بالبراءة المفترضة للمستهدفين، أي عدم انخراطهم في مقاومة مسلحة ضد المعتدين، وهو ما يغفل أوضاعاً تكون الحرب فيها تعذيبية من جهة الأقوياء، وإن ووجهوا بمقاومات مسلحة. وهذه ليست مجرد مشكلات نظرية، فميثاق الأمم المتحدة الخاص بالجينوسايد يوجب جهداً دولياً لوقف هذه الجريمة، وهو ما يدفع الضحايا أو ممثليهم إلى التأكيد على أن ما يجري من مذابح هو إبادة من أجل شرعنة المساعدة الدولية في وقفها، وما يدفع المرتكبين إلى تصوير الأمر قمعاً لتمرد غير شرعي أو «حرب ضد الإرهاب» مثلما فعل الحكم الأسدي منذ وقت مبكر من الثورة السورية، ثم ما يدفع نافذين دوليين غير راغبين في مساعدة الضحايا إلى إنكار صفة الجينوسايد (إدارة كلينتون أوصت دبلوماسييها بعدم استخدام كلمة الجينوسايد بخصوص مجازر التوتسي في رواندا عام 1994، لأن ذلك موجبٌ للتدخل، مما لم تجد الإدارة الأميركية مصلحةً لها فيه).
على أنه ليس بين مشكلات المفهوم اقتضاء عددٍ مليونيٍ أو بمئات الألوف من الضحايا كي نتكلم على جينوسايد. قتل بالكاد تسعة آلاف في مجزرة سربرنتشا في البوسنة عام 1995، لكن يقر أكثر الدارسين بأن الأمر يتعلق بجينوسايد، استهدف فيه الضحايا لهويتهم: مسلمون، وكانوا فوق ذلك مسالمين، وتوفرت نية تحطيم مجتمعهم من قبل القوميين الصرب. مثل ذلك ينطبق على الإبادة الإيزيدية على يد داعش، ربما الضحايا بالآلاف القليلة فقط، لكن الجماعة استهدفوا (قُتل الرجال في سن الحرب، وسُبيت النساء واستُعبدنَ جنسياً…) لكونهم هم من هم وليس لأي شيء فعلوه.
على أنه قد يكون من الأنسب الكلام على مجزرة إبادية (وهو مفهوم اقترحه ليو كوبر، أحد دارسي الجينوسايد)، بخصوص الاستهدافات الجزئية، التي يقتل فيها عشرات هناك ومئات هناك. مجزرة التضامن مجزرة جينوسادية أو إبادية دون شك، قتل فيها مدنيون، بنية تدمير مجتمعهم، ولكونهم هم من هم، أي لاعتبارات هوياتية، ثم لكونهم مدنيين غير مسلحين.
وما سبق قوله عن التكوين الإبادي للنظام ينطبق على التشكيلات الطائفية السنية التي تستهدف العلويين بما هم علويون. حيث نتكلم على طائفية وتطييف، فإن باب المجازر الإبادية ينفتح على وسعه. لنا في سورية تاريخ كاف خلال 52 عاماً من الحكم الأسدي لإثبات ذلك.
يبقى أنه ليس من الضروري حصر النقاش في شأن القضية السورية بصورة ضيقة في إثبات أن ما جرى جينوسايد. لعل الأنسب أن نستند إلى التجربة السورية لنقد مفهوم الجينوسايد، ونستند إلى مفهوم الجينوسايد وأدبياته من أجل إضاءة الأوضاع السورية.
تشبيح وتشليح
يبرز الباحثان أن ما سمّياه «القتل الجماعي الممنهج» الذي جسدته مجزرة التضامن هو أحد أوجه مُركَّب أوسع يشمل كذلك السجون، أو بالأصح الاعتقال ومعسكرات التعذيب والقتل الصناعي، ثم الاعتداءات الجنسية على النساء، وعلى رجال وأطفال، على نحو يُقصد منه الإذلال وتحطيم المجتمع، ثم الاستغلال الاقتصادي، من سُخْرة ورشاوى تدفع للنجاة أو الحصول على معلومات عن معتقلين ومُغيَّبين، وبالخصوص نزع الملكيات. شهدت السنوات الأحد عشر الماضية أوسع عمليات نزع ملكية وتحويل ملكية عرفتها سورية في تاريخها، ولا تزال غير مدروسة بصورة وافية. أمجد يوسف يستثمر لوحده ثلاثين محلاً استولى عليها في حي التضامن وحده. النطاق الكامل لنزع الملكيات وتحويلها إلى محظيي النظام صعب التصور، لكن الأمر يتعلق بـ«ثورة اجتماعية»، ثورة على المجتمع في واقع الأمر، أوسع نطاقاً بما لا يقاس من ثورة سابقة جرت في ثمانينات القرن العشرين بعد سحق تمرد اجتماعي أول على الحكم الأسدي.
كانت تجارة الاعتقال في سجون ومعتقلات النظام السوري موضع بحث أجراه سلطان جلبي ونشر في نيسان 2020، يدرس حالة 100 معتقل، ويُظهِرُ أن 85 من أُسرهم تعرضت لمساومات وابتزاز من قبل سماسرة مقربين من النظام، بعضهم ضبّاط مخابرات، وأن 75 أسرة دفعت أموالاً لمعرفة مصير أبنائها، وأن مجموع ما دفع من مال يبلغ 800 ألف دولار أميركي، أي فوق 10 آلاف دولار من الأسرة الواحدة. يُقدِّرُ الباحث مجموع ما دفع من أموال لهذا الغرض بما بين مليار وملياري دولار.
ويبدو العمل القسري أو السخرة شيئاً جديداً نسبياً في تاريخ الأسدية. في سنوات حكم حافظ، لم تتوارد معلومات عن استخدام معتقلين أو غيرهم لأعمال سخرة (كنا نستخدم الكلمة في المسلمية، سجن حلب المركزي، لتسمية عمل من يتناوبون يومياً منا على القيام بالخدمة الجماعية لرفاقهم). لكن هناك معلومات منذ عام 2013 عن استخدام معتقلين لحفر خنادق لقوات النظام، ورد أَبكُرها في حدود ما أعرف في تقرير لمركز توثيق الانتهاكات كانت كاتبته الرئيسية هي رزان زيتونة عن تمكن خمسة من هؤلاء المعتقلين من الهرب. تقرير الباحثين يذكر السخرة في إطار «الاستغلال الاقتصادي» للمعتقلين دون مزيد من التفاصيل. وفي غياب معلومات موثوقة تتيح الجزم، أُقدِّرُ أن الأمر غير واسع النطاق بعد.
يجمع بين السخرة وتجارة المعلومات عن المعتقلين والمغيبين ونزع الملكيات ما يمكن تسميته التشبيح من أجل التشليح. ويعني التشليح بالمحكية السورية الاستيلاء على ما يخص الغير بالقوة والحيلة. أو باختصار شديد وضع المسدس في الرأس (التشبيح) للاستيلاء على ما بحوزة الشخص (التشليح). السلطة في شكلها العنفي المجرد هي مصدر الثروة هنا، وليس الثروة هي مصدر السلطة مثلما هو الحال في النموذج الرأسمالي. ولأن السلطة هي مصدر الثروة، فإن الموقع القيادي في اقتصاد التشليح هو لمن يملك المسدس من أمثال صاحب المحرقة أبو علي حكمت، أو «هتلر سورية»، أو أمجد نفسه، أو بشار الأسد.
على أن الاقتصاد السياسي للتشبيح العام، من تجارة الاعتقال إلى المجزرة، ومن التهجير إلى السخرة، يفتح أفقاً لدراسة الأوضاع السورية، يضع الطائفية في مكانها. الطائفية منجمٌ لِولاءٍ متواضعِ الكلفة، تعود عوائده من سلطة وثروة على المستثمرين في المنجم، الشبيح العام. إنها أداة حكم فعالة لا يصح إهمال تناولها، لكن لا يُختزَل إليها كل شيء آخر. ومنذ أن نتكلم على اقتصاد سياسي للمجزرة وأخواتها، فإننا نتكلم على انقسام اجتماعي مغاير وعلى شراكات غير محصورة طائفياً، يجتمع فيها جمال الخطيب السني مع أمجد يوسف العلوي ونجيب الحلبي الدرزي.
وقد يمكن النظر في «إعادة الإعمار» التي تتكلم عليها دوائر النظام بين حين وآخر كتطبيع لنزع وتحول الملكيات الهائل لمصلحة طبقة المنتفعين الجدد. هذا على كل حال ما تظهره ليلى فنيال في الفصل الأخير من كتابها المهم: التمزيق حرباً، تفكيك سورية 2011-2021. أي عملياً ترجمة الثورة المضادة للمجتمع إلى واقع مُكرَّس، أو نقل تحويل الملكيات من واقع محقق بالاستيلاء إلى واقع مقنن وموثق.
في المجمل، تَصلُح مجزرة التضامن كنافذة نطلّ منها على مشهد سورية خلال أحد عشر عاماً، أو بالأصح ثغرة سرية خلّفها حجر سقطَ من جدار، نختلس منها الفرجة على حياة سورية وموتها، مثلما فعل بطل رواية القوقعة لمصطفى خليفة. ومن يَرى يروي.
موقع الجمهورية
—————————-
في رأسي حفرة حي التضامن/ عمار عكاش
ادخل حفرتك أيها الأرنب البريء، اضرب أنفاقَكَ لكن احذر أساساتِ البيت الطينيّ واحذر جذورَ خُضرواتي، خذ ذيلك الفرائيّ وأسنانك وكفّيك وجوزتكَ يا سنجابي، ونم آمناً في حفرةٍ مرسومةٍ في تجاعيد الجدّة.
يا عامل الطريق المكدود اردم الحفرة وراءَك، تكفيني حفرةٌ واحدة في رأسي. ثقوب جسمي حفرٌ، تتساقط أيديهم عيونهم خواتمهم عَصابَاتُ رؤوسهم المرتجلة من عيوني، من أنفي، من أذنيّ، وكأن كأسي طفحتْ. أمشي بثقلٍ، لن أكون خفيفاً بعد اليوم، في رأسي حفرةٌ أحملها، تحملني، أتدحرج إليها، أنام فيها، أصعد جوانبها وأقضي نهاراتي… ابتعدوا أيها الاسطنبوليّون عنّي إلى عاديّاتِ حياتكم، فلربّما ينتقل الموت كالجذامِ بالعدوى.
كابوس
مثل طيور الماء يعود الكابوسُ، مثل مصيرِ غزالٍ عَطِشٍ لا مفرّ له من ماءٍ ومن أنياب فهدٍ، ومثل رقصة ذكر النعام في مواسم التكاثر والبقاء يغويني كابوسي. لم أنْسَ هويتي الشخصية قبل بلوغِ حاجزٍ، دمغتي الأبدية مثل شاماتٍ في جسدي لم تروها، هذه المرّة طيرُ الحلمِ ضبطَ بوصلةَ الشمال بدقةِ السنونو ولم يعبر الحدودَ خطأً، هذه المرة لم أجدْ نفسي مرّةً أخرى أخدمُ علماً لم أختره ولم يظلّلني؛ يكبر العلمُ مثل مجزرةٍ أو يصغر مثل قضْمةِ شونْدرٍ مسلوقٍ في فم طفلٍ.
هذه المرة عيوني منطفئة كسيجارة قديمةٍ مجعلكة في منفضة السيّارة، ركلةٌ في ظهري أسقطُ حيث لا أعلمُ فوق ركامٍ أحلم أن يكون أغضانَ زيتونِ القرى على دروب حلب، أُكذِّبُ عظامي التي طَرْطقَتْ فوق عظامهم، الصوت صوتُ رصاصةٍ، دمي يدفّئ جسدي، يبدو أنني أموت، أيها الأحياء انظروا في عيني قاتلي دون أن تَطْرفوا واحملوا عن أمّي عبء النظر في وجهه وحيدةً، احملوا عني عبء الموت مجهولاً أعمىً مثل جنين غير مكتملٍ… امنحوا جثتي اسماً.
الموتى يلومون الأحياء
الموتى إن ماتوا دون إذنٍ مسبقٍ، دون تحذيرٍ، دون إرادةٍ، دون خوفٍ يليق بهيبة الموت واسمه سيّء السمعة، إن شعروا أنهم خُدِعوا بوعود بغدٍ أجمل، وإن لم يجرّبوا امتطاء حصان البحر مثلك إلى عالم جديدٍ، سيلعنون الأحياءَ قبل قاتليهم، فلا يُلام القاتل إنما يتّخذُ في أفضل الحالاتِ شكل دوائر متّحدةِ المركز للتدريب على الانتقام، يُطلَقُ الرصاص عليها حتى ينجح المصوِّبُ في تصويب منتصف الدائرة، لكن الدائرة بعيدةٌ بعيدة، أبعدُ من عين الصقرِ. لذلك يعود هؤلاء الموتى في هيئاتٍ كثيرة إلى أحبّائهم الناجين الندّابينَ البكّائين، فالموتى متى ماتوا يلبسون أجنحةً تعينهم على الطيران والتخفّف من عبءِ الجغرافيا، يعودون في صورة اللقلقِ على شاطئ بالاتBalat واللوْمُ ينقِّط من عرفه وقدميه الناحلتين مثل ملحِ بحريٍّ يترسب في جلدكَ، يحفظ لحمك من التفسخِ. تعود إلى البيت وتستحمّ، ويتساقط الملح منك دون نهاية حتى تكاد تسلخ جلدك، تصرخُ، تزعقُ، تنشبُ أظافرك في صدرك وتحاول رسم وجه قاتلٍ كوشمٍ باقٍ إلى الأبدْ.
يوميّات الموتى والأحياء
والموتى يتخذون هيئاتٍ تناسبُ رؤيتك الشخصية في الحياةِ، لا تعزّيهم الكلماتُ الكبيرة، فلكي ينسوا أنّهم موتى سيرافقون يوميّاتك. وما دمتُ أخدّر رأسي بالكافيين والسيجار، سيتّخذون صورة فنجان الاسبريسو والتبغ، يا لدهائهم، كمْ يحسنون التنكّرَ. أسمع منهم صدىً غريباً كصوت انطباقِ شِرْكٍ “لا تنسانا”، مثل لومِ أمّ محزونة تغني على بقايا بردى: “سكابا يا دموع العين سكابا”.
وكلما طلبْتُ الاسبريسو لا تبخل عليَّ أوزْلَم Özlem بحسّ الصديقة وبحسِّ صاحبة مقهىً أنيقة كل يومٍ بفنجانٍ جديد يقول لي لست وحدك يا صديقي السوري في حِدادكَ الطويل؛ فنجانٌ لامعٌ دون إسرافٍ كالنحاس العتيق، فنجان كبيرٌ أبيض منقّطٌ بضرباتِ رسّامِ أزنافور على القماش. يا صديقتي لا يهمّ أن تغيري الفنجان، العبرة في كافيينٍ يخدّر الرأس، فالموتى إن عجزوا عن الحُلولِ في قهوتي، سيأتون على صورة مَسْكَةِ الفنجان ويتشبّثون بأصابعي، يلومونني فالخدَرُ يوازي النسيان أحياناً.
وأنا أمشي على ساحل بالات Balat، أُسرِعُ فجأة وكأن دبّوراً لسعني، أرى قناصاً على سطح المدرسة اليونانية، فلا حُرمةَ في الحرب للأمكنة الجميلة، ويضربني ضوءٌ كشَّافٌ مُهيبٍ ساطعٌ مثل ألف شمسٍ بعد غيمة، فأعدو كاليهوديّ الذي استغلّ نوبة تبديل الحرس، أهرع نحو السياج هرباً من الهولوكوست، يغرِقُني الضوء، يائساً أنوي الفرار من رصاصةٍ محققة. أركض وأركضُ، أزرعُ الساحل ثلاث مراتٍ ذهاباً إياباً ثم أعود سالماً إلى بيتي! أعود سالماً نَعم، فحجارة بالات Balat الكريمة المُغبَرَّةُ بوجوه يونانيّينَ تركوها، لن تبخل بدموعها على سوريٍّ ظنّها حجارة حلب القديمة.
رصيف 22
————————
==================
تحديث 02 حزيران 2022
—————————–
أنباء إعدام أمجد يوسف: عن العدالة كما يراها النظام السوري/ كارمن كريم
مجزرة التضامن وجريمة أمجد المروعة، هما بداية التصدع في جبل النظام الجليدي، بخاصة في العلاقات التي تجمع الأفراد المنتمين إلى الجهاز الأمني وتلك التي تربطهم بالنظام، فمن التالي؟
تعود قصة الضابط السوري أمجد يوسف إلى الظهور مجدداً، هذه المرة ليس لكونه مرتكب مجزرة مروعة وحسب، بل لأنه متهم محكوم عليه بالإعدام، من قبل النظام الذي عمل لأجله وارتكب مجازرَ تحت رعايته.
ظهر أمجد راهناً في فيديو مصور يعود لعام 2013، يرتكب فيه مجزرة في حي التضامن بدمشق بحق 41 ضحية، وكانت شائعات تحدثت عن قيام النظام باحتجاز أمجد او “الإبقاء” عليه، حتى أكد تقرير صدر منذ أيام عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن أمجد محتجز بالفعل منذ بداية شهر أيار/ مايو 2022، فهل سيعدم النظام السوري أمجد بالفعل؟
أمجد محتجز في مكان عمله!
نشر صدام حسين وهو صحافي سوري مقيم في لبنان ومتابع بشكل وثيق للوضع السوري الداخلي منشوراً على “فيسبوك” يقول فيه إن أمجد يوسف، مرتكب مجزرة التضامن سيعدم قريباً في ساحة عامة.
الأنباء انتشرت سريعاً وكل التأكيدات أتت من مصادر لكن ما من موقف رسمي بشأن مصير، أمجد إلا أن معظم التسريبات نقلت أن أمجد محتجز في فرع المنطقة 227 أو ما يعرف بالأمن العسكري، وهو المكان الذي كان يعمل فيه خلال ارتكاب جريمته، لكن لا معلومات دقيقة أو رسمية بشأن مصيره وإن كان سيعدم أم لا.
لم يعرف عن النظام السوري يوماً شفافية في التوقيفات والمحاكمات، لذلك لا ينتظر أن يتغير الأمر في هذه الحالة.
الأكيد هو أن قصة أمجد أربكت النظام، ووضعته في موقع ملتبس، فمن جهة، ارتكب ضابط من جهازه الأمني مجزرة بحق المدنيين العزّل أمام الكاميرات مباشرة ولا يمكن بأي طريقة تكذيب ذلك، ومن جهة ثانية على النظام تبرير فعلة أمجد، ليس أمام العالم فقط بل أمام الموالين مِمَن استنكروا المجزرة.
الأهم هو كيف سيتعامل نظام الأسد مع مجرم حرب ينتمي لمنظومته القائمة على الجريمة؟ فلو صفح عنه سيبقى الدليل على وحشية النظام حراً يمكن استخدامه في محاكم دولية كما حصل في محاكمات “كوبلنز” الألمانية، ولو تخلص منه سيكون القتل بمثابة دليلٍ ضده، لكن يبدو أن النظام سيختار التخلص من أمجد وتحويله كبش فداء عوضاً عن النظام.
لماذا يختار النظام الإعدام سواء حدث في ساحة عامة أو في أحد أقبية الأفرع الأمنية؟ بداية من البدهي أن النظام سيتخلص من أمجد سواء حدث ذلك على العلن أو في السرّ، لا يُبقي النظام على أدلة ضده، حتى ولو بقي أمجد داخل سوريا، إلّا أنه يظل دليلاً قاطعاً ضده، لذلك فأول خطوة ستكون الاحتجاز، وفي جميع الأحوال أمجد غير قادر على الخروج من سوريا لأنه سيحاكم باعتباره مجرم حرب. تتنوع فرضياتُ أسباب نهاية أمجد وليس أقواها الضغط الروسي على النظام للتعامل مع فضيحة مجزرة التضامن بخاصة في ظل انشغال الروس بالحرب على أوكرانيا، لن يكون من أولوياتها أمجد على الرغم من أهمية قضيته، إلا أنه يبدو منطقياً سعي النظام إلى تبييض صفحته وإثبات نيته الحسنة، في ظل عودة علاقاتها العربية للصعود وأحلامه في العودة إلى الساحة العالمية كنظام حاكم وليس كمجرم حرب.
نظامٌ لا يؤتمن
لا يستطيع عاقل تجاوز ما ارتكبه أمجد، حتى النظام يعرف ذلك، ومهما أبدى هذا النظام من وحشية في السرّ ضد شعبه أو عبر صور وفيديوات لضباط وعناصر له كان ينكرها جميعها، إلّا أنه يدرك أن فعلة أمجد ما كان يجب أن تظهر إلى العلن، ويجب التعامل معها، حتى لو كان ذلك اعترافاً ضمنياً بمئات المجازر الأخرى، إنه الاختيار بين أهون الشرين بتصفية أمجد.
سيكون إعدام أمجد إذا ما حصل فعلاً لحظة مفصلية في علاقة النظام مع أجهزته الأمنية من أفرادٍ أوفياء، إذ سيثير شكوكهم حول الجرائم التي ارتكبوها وإن كان سيأتي دورهم يوماً!
هي رسالة شديد الوضوح، هذا النظام لا يؤتمن، مهما كنتَ وفياً له، لن يتوانى عن التخلص منك في حال شكلت تهديداً له، فبينما اعتقد أمجد أن أفعاله ستكون بمثابة خدمات جليلة يقدمها للنظام ليربت الأخير على كتفه، إلّا ان العكس هو ما حدث، قصة أمجد رسالة قاسية للموالين والعاملين في هذه المنظومة الديكتاتورية.
كل هذا وضع المؤيدين في حيرة من أمرهم بخاصة الذين دعموا أمجد بحجة أنه يقوم بعمله أو ممن قارنوا بين ضحايا المجزرة ومن فقدوهم في سجون المعارضة المسلحة والإسلامية، فمن جهة سيشعر البعض بأن النظام خانه بإعدام أحد مخلّصيه ومن جهة أخرى سيفشل آخرون في شرح ما حدث في قصة أمجد، والفشل هو اعتراف بالجريمة.
بداية التصدع في جبل النظام الجليدي
ما يحدث مع أمجد من احتجاز أو حتى إعدام محتمل في المستقبل القريب أو تصفية في السرّ، له دلالات أوسع، أمجد ارتكب غلطة الشاطر، ليس لأنه أقل ذكاء بل لأن المنظومة بحد ذاتها تقف على أرضية هشة، وأمجد ليس الأول، فالضابط أنور رسلان حكم بالسجن مدى الحياة في ألمانيا لارتكابه جرائم حرب وكذلك الطبيب علاء موسى ما زال يخضع للمحاكمة. يمتلك هذا النظام من الجرائم ما يفوق قدرته على إخفائها، والتحكم بجميع أفراد منظومته الأمنية وإبقاؤهم تحت نظره هو أمر شبه مستحيل، إذاً ولأن الجريمة أكبر مما نتوقع ستستمر قصصٌ كأمجد وأنور وعلاء تظهر شيئاً فشيئاً وعلى رغم المأساة إلا أن تحقيق العدالة على هذا النحو هو خطوة أولى للسوريين.
مجزرة التضامن وجريمة أمجد المروعة، هما بداية التصدع في جبل النظام الجليدي، بخاصة في العلاقات التي تجمع الأفراد المنتمين إلى الجهاز الأمني وتلك التي تربطهم بالنظام، فمن التالي؟
هل سيثق القتلة من ضباط وجنود بأن النظام سيحميهم فيما لو اكتشف أمرهم، وبدون شك ستغدو رحمة الغرب في حكمٍ بالسجن المؤبد كما حدث مع الضابط السابق أنور رسلان أهون من تصفيته وعائلته على يد النظام. لا شك في أن عدداً من المجرمين سيفكرون على هذا النحو.
من المثير للسخرية كيف يتعامل النظام السوري مع قصة أمجد كتعامله مع معتقليه، وشتان بين التشبيهين، لكنه يكرر الأمر ذاته فيحتجز أمجد من دون مذكرة توقيف، اختفاء قسري، لا محاكمة ولا أي فرصة لتبرير ما فعله، لا فرصة للتواصل مع محامٍ أو الدفاع عن نفسه، وبينما يفترض أن يكون التعامل مع قضية أمجد يوسف إثباتاً لعدالته، يأتي الاحتجاز والإعدام المتوقع ليقولا إن عدالة هذا النظام مجرد كذبة أخرى.
درج
————————-
================
تحديث 22 حزيران 2022
——————-
«عائلات تُركت تتدبر أمرها بنفسها»
جاء الكشف عن تفاصيل مجزرة التضامن في السابع والعشرين من نيسان (أبريل) الماضي، ثم أعقبه تسريب الفيديو المروّع للمجزرة نفسها، وبعدها بأيام قليلة جاءت مَشاهدُ العائلات التي تنتظر أبناءها المعتقلين على أمل الإفراج عنهم بعد مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري. وقد أثارت هذه الوقائع مجدداً نقاشات حول ضعف الآليات الموجودة لدعم الأهالي في رحلتهم للعثور على الأحباب المُغيَّبين، وحول الوسائل التي يمكن اتّباعها لمساعدتهم، وتجنيبهم شطراً من الآلام التي يسببها البحث في الفيديوهات والصور والشوارع ومراكز الاحتجاز والأفرع الأمنية وصفحات الإنترنت على أي معلومة أو ضوء في آخر النفق.
وفي السادس والعشرين من أيار (مايو)، أصدرت سبعة عشر منظمة سوريّة بياناً مشتركاً تدعم فيه إنشاء «آلية مستقلة دولية وشاملة للتعامل مع ملف الأشخاص المفقودين في سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة التي قدمتها عائلات المفقودين»، مؤكدة أن العائلات «تُركت مرة أخرى لتتدبر أمورها بنفسها»، وأن هناك حاجة ماسّة إلى «الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين»، بحيث «لا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن».
لماذا نحتاج آلية دولية؟
مبادرة تعافي التي تضمّ مجموعة من الناجيات والناجين كانت إحدى الجهات الموقّعة على هذا البيان، ويقول أحمد حلمي مدير البرامج في المبادرة في حديث له مع الجمهورية إن «حجم الاختفاءات القسرية في سوريا غير مسبوق منذ الحرب العالمية، ما يضع المجتمع السوري أمام تحدٍ هائلٍ يتطلب موارد كبيرة ومستدامة، وتنسيقاً عالياً بين جميع الجهات والخبرات العاملة على هذا الملف. نعتقد أن الصفة الدولية للآلية ستسمح لها بتوفير موارد مستدامة، وتعطيها الاختصاص لدفع جميع الجهات الدولية والمحلية للتنسيق معاً نحو كشف مصير وأماكن تواجد المختفين قسراً». أما بالنسبة للتواصل مع الأهالي ودعمهم، فيرى حلمي أن المنظمات السورية تقوم فعلاً بجانب من هذه المهمة، وأن هناك تنسيقاً وتعاوناً بينها على بعض القضايا والملفّات، لكنه يضيف أنه «مهما بلغ التنسيق بين المنظمات السورية، فهو لن يكون كافياً للتعامل مع الحجم الكبير للقضية بسبب محدودية مواردها وعدم استدامتها». ويأمل حلمي أنّ «إنشاء آلية جديدة سيعالج أزمة الثقة لدى الأهالي تجاه الآليات والجهات الموجودة حالياً»، مضيفاً أنه «من المهم توضيح أنه لا يوجد للسوريين حالياً جهة أو مرجعية موحدة وواضحة يستطيعون التبليغ عن اختفاء أقاربهم لديها، بل هناك جهات متعددة».
ياسمين المشعان، من رابطة عائلات قيصر، تقول في الشأن نفسه إن «آلية ذات طابع دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ستسمح بتوحيد الجهود الهادفة لكشف المصير وتمنع تشتت وضياع المعلومات، وتحدّ من معاناة الأهالي الناتجة عن تعدد الجهات العاملة على هذه القضية واختلاف منهجياتها ومقارباتها». وهي تشرح أن «عملية كشف المصير ستكون طويلة الأمد ومعقدة، وخاصة ضمن ظروف استخدام المنتهكين وسائل متقدمة لإخفاء آثار جريمتهم وتدمير الجثامين لتعقيد عملية البحث، مثل حرقها واستخدام الكلس ورميها في الآبار أو الحُفَر مثل حفرة الهوتة، الأمر الذي يستدعي استخدام تقنيات ومنهجيات متعددة، وتكاتف جميع الجهود من المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية تحت إطار موحد ومظلّة دولية».
ترى ياسمين أنه بعد الحجم الهائل للاستقطاب السياسي في الكارثة السورية، لا بد أن تكون الآلية إنسانية مستقلّة: «إن استقلالية هذه الآلية واختصاصها العالمي سيوفران لها الفرصة لكسب الثقة وجمع الخبرات والموارد والبيانات على طاولة واحدة ضمن إطار عمل واحد. ونأمل أن طبيعتها الأممية ستسمح لها بالتواصل مع جميع السلطات الرسمية وسلطات الأمر الواقع، والضغط عليهم للتعاون من أجل توفير وجمع معلومات عن المخفيين قسراً بهدف كشف مصيرهم».
تحدثنا أيضاً إلى معتصم السيوفي، المدير التنفيذي لمنظمة اليوم التالي، وهو يقول في الاتجاه نفسه إن المنظمات السورية لا تستطيع تنفيذ المهمة بكاملها دون آلية دولية، و«ذلك لسببين: الأول أن النظام السوري لن يقبل طوعاً بالتعامل مع المنظمات السورية، والثاني أن هذه المنظمات لا تمتلك تفويضاً بموجب القانون الدولي، ولا تمتلك الإمكانات التقنية التي هي مسألة شديدة التعقيد، ذلك أنه لا يكفي أن تتلقى جهة حقوقية معلومات من الأهالي عن أبنائهم حتى تقوم بعملية البحث». ويشرح السيوفي أن هناك مهمات كثيرة لا يمكن للمنظمات السورية التصدي لها على الإطلاق، من أبرزها الضغط على النظام السوري، وأيضاً على سلطات الأمر الواقع الأخرى، للتعاون في عملية البحث عن مصير المختفين قسراً، مشيراً إلى أنه رغم أن النظام هو المرتكب الأكبر للانتهاكات، إلا أن ثمة مفقودين على يد جهات أخرى عديدة.
والعائق الأول أمام الكشف عن مصير المختفين قسراً هو الجهة المسؤولة عن تغييب العدد الأكبر منهم، النظام السوري الذي هو سلطة الأمر الواقع الأكبر في سوريا، والذي يرفض طبعاً أي شكل من أشكال التعاون على هذا الصعيد. وقد تحدثنا إلى مارية العبدة، المديرة التنفيذية لمنظمة النساء الآن الموقِّعة على البيان، التي قالت في هذا الشأن إننا «حتى اللحظة وللأسف ما نزال في مرحلة النزاع. سيكون من الممكن تشكيل آلية وطنية عندما تنتهي الحرب وبعد الوصول إلى تحوّل سياسي ومصالحة وطنية، غير أننا نشهد حالات اختفاء قسري إلى اليوم، ولذلك نحتاج إلى آلية دولية للتعامل مع هذا الظرف».
يقول معتصم السيوفي في هذا الشأن إنّه «لا نية لدى النظام إطلاقاً بالتعاون في هذا الملف، حتى أنه في قرار العفو الأخير لم يكن هناك قوائم رسمية بأسماء المشمولين بالعفو أو المطلق سراحهم». وإذ يرى السيوفي أننا نحتاج إلى آلية دولية لأسباب تقنية وواقعية تحول دون قدرة المنظمات السورية على إنجاز الكثير، فإنه يقول أيضاً إن لديهم بعض التساؤلات والهواجس: «ما هي ضمانات نجاح هذه الآلية في الوقت الذي لم تنجح فيه آليات أخرى مثل لجان التحقيق الأممية؟ وهل هناك ضمانات بشأن تعاون النظام أو كيفية إجباره على التعاون؟ وفي ظل غياب الضمانات، ألن يؤدي ذلك إلى تجديد دوامة قلّة الثقة وخيبة الأمل لدى ذوي الضحايا؟ ومع غياب الإرادة السياسية لدى الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن للضغط على الأطراف المُتّهمة للكشف عن مصير المفقودين، فهل سيكون هناك فائدة جديّة من تأسيس آلية جديدة؟ وأيضاً، إذا تمّ تأسيس هذه الآلية دون مراعاة جهود المحاسبة، ألا يمكن أن نرى جهة تسيء استخدامها، كأن تُعطى مكافآت للنظام السوري مقابل التعاون مع هذه الآلية، التي ستتوسل إليه لكشف مصير الناس أو لاستقبال موظفيها».
يشرح السيوفي أن هذه قضايا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكنه يؤكد أن منظمة اليوم التالي «ليس لديها اعتراض جوهري على البيان»، الذي وقّعت عليه «دون أحكام مسبقة على الآلية». مضيفاً أن المشكلة المتعلقة بغياب الإرادة السياسية وعدم وجود ضمانات لا تتعلق بالنظام وحده، لأن «هناك أطرافاً أخرى تخفي سوريين وسوريات من مختلف الأطياف والمناطق، وهذه الأطراف هي الأخرى محمية من جهات إقليمية ودولية. هل هناك إمكانية لإجبارهم على التعاون مع الآلية؟».
الصحفية ميسا صالح هي شقيقة سمر صالح، المُغيَّبة مع محمد العمر على يد داعش منذ العام 2013، وكانت قد نشرت في موقع الجمهورية مقالاً بعنوان سماسرة التغييب، تحدثت فيه عن عملية ابتزاز تعرضت لها هي وعائلتها. عن الفارق الذي يمكن أن تُحدِثَه آلية دولية، تحدثت ميسا صالح عن معاناة أساسية عاشتها عائلتها، وعائلات جميع المغيبين على يد داعش، تتعلق بإهمال مطالباتهم المتكررة باتخاذ إجراءات جدية لكشف مصير المختفين والمختفيات قسراً، وهي الإجراءات التي كان لاتّخاذها أن يخفف معاناة عدد كبير من السوريين، وأن يجنّب عائلات كثيرة عمليات الابتزاز التي تتعرض لها مقابل معلومات مزعومة عن أحبابها.
تقول ميسا: «طالب كثيرون من عائلات المخطوفين مراراً بالضغط جدياً على التحالف الدولي وعلى قوات سوريا الديمقراطية لاتخاذ إجراءات عديدة، أبرزها فتح المقابر الجماعية والبحث في رفات الضحايا عبر جِهات وفرق متخصصة، ووضع كل المعلومات التي أمكن الحصول عليها من سجون داعش في عهدة جهات موثوقة والاستفادة من كل ما يمكن أن تتيحه من معلومات بشأن مصائر أحبابنا، والتحقيق الجدي مع عناصر داعش المحتجزين، بما في ذلك المحتجزون في سوريا أو الذين تم نقلهم إلى دولهم. لم يحدث شيء من هذا، حتى أن ما يتعلق بمصير المخطوفين لم يكن جزءاً من المفاوضات التي جرت مع قادة داعش مراراً أثناء مراحل الحرب، كما لا يبدو اليوم أنها جزءٌ من صفقات نسمع عنها مع عناصر أو قادة محليين في داعش. ثمة عجز تام من جانب المنظمات عن تقديم أي شيء على هذا الصعيد حتى الآن، ولا نعرف إذا ما كانت آلية دولية كتلك التي يطالب بها البيان ستحدث فرقاً، لكن يبدو أن الأمر يتعلق بالإرادة السياسية لدى الدول والجهات صاحبة السلطة والقرار، وهذه الإرادة لا يمكن أن تتشكل دون ضغط جدي لا يبدو أنه يتم القيام به بشكل كافٍ. نأمل أن آلية دولية يمكن أن تغيّر قليلاً من هذه المعادلة، لأن هناك بنك معلومات هائل دون شك لدى قسد والتحالف الدولي، وهذه المعلومات يمكن أن تقودنا إلى معرفة مصير كثيرين من المخطوفين».
عن تأسيس الآلية وعملها
ترجع المطالبات بتأسيس آلية دولية للمفقودين في سوريا إلى شهر أيار (مايو) 2021، عندما أصدر تحالف من خمس منظمات سورية بقيادة الناجين وعائلات المفقودين ورقة بحثية تتضمّن خطة لإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في مصير المفقودين في سوريا. ويضم هذا التحالف رابطة عائلات قيصر ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ومسار (تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية – داعش) ومبادرة تعافي وعائلات من أجل الحرية، وهي المجموعة التي باتت تعرف باسم مجموعة الميثاق منذ إطلاقها ميثاق الحقيقة والعدالة في شهر شباط (فبراير) 2021. جميع هذه المنظمات موقعّة على البيان الذي يدعم إنشاء الآلية اليوم.
تلعب روابط الناجين وعائلات الضحايا دوراً محورياً إذن في هذه الجهود، وفي هذا الشأن تقول مارية العبدة إن «البيان يتضمن مطالب ونقاط أساسية واضحة، وإن ما تقوم به روابط الناجيات والناجين والأهالي التي أصدرت الميثاق العام الماضي، والتي تقود اليوم عملية المطالبة بإنشاء الآلية، يدعو إلى الفخر. تتميز الروابط بوضوح مطالبها، وبتواصلها مع شريحة واسعة من الأهالي والمعتقلين والمعتقلات السابقين، وأرى أنّ المطلوب منا كمنظمات سورية، والمطلوب كذلك من المنظمات الدولية، هو التركيز على ما يمكن تسميته المقاربة المتمحورة حول الضحايا، بمعنى أن نكون أذناً صاغية لما تطلبه هذه المجموعات».
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير كان واحداً من المنظمات الموقِّعة على البيان، وعن سبيل تأسيس هذه الآلية يقول داني بعّاج مدير المناصرة في المركز إن «الآلية المطروحة آلية أممية منبثقة عن الأمم المتحدة، والوضع الأمثل أن تتشكل بقرار صادر عن مجلس الأمن، وهو ما سيصطدم على الأرجح بفيتو روسي، وسيكون لدينا عندها خيار الجمعية العامة. على سبيل المثال، الآلية الدولية الخاصة بجمع الأدلة على جرائم الحرب والانتهاكات في سوريا (IIIM) أُنشئت بقرار من الجمعية العامة، ما يعني أنه يمكن إنشاء الآلية بقرار من الجمعية العامة مع إعطائها الولاية القانونية الكاملة. ويستند المسار الذي نعمل عليه الآن إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 228/76، الذي أوصى بإنشاء الآلية وطلب إعداد دراسة بهذا الشأن. والمعلومات التي لدينا تقول إن الأمين العام للأمم المتحدة طلب بالفعل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان العمل على دراسة تصدر باسمه بهذا الخصوص».
يقول معتصم السيوفي إن «هناك مطالبات للنظام السوري بكشف مصير المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين منذ سنوات طويلة جداً، ولكن النظام لم يتعاون في هذ الإطار. أما المطالبة بإنشاء آلية دولية بتفويض خاص فهي حديثة العهد نسبياً، وهي تتأسّس اليوم على مواد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 228/76، وهي مواد مبنية على توصيات اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق التي تخلص إلى أن معالجة ملف المعتقلين بحاجة لإرادة وتفويض دوليين».
وكان قرار الجمعية العامة المشار إليه قد صدر في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021، وتنص المادة 63 منه على أن الجمعية العامة «تلاحظ توصـية لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري»، فيما تطلب المادة 64 منه أن يقوم الأمين العام «بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال الآليات والتدابير القائمة، لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستناداً إلى توصيات لجنة التحقيق، بمشاركة كاملة ومُجدية للضحايا والناجين وأسرهم، وبالتشاور مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة».
ثمة العديد من اللجان الدولية والآليات ذات الصلة، من بينها الآلية الدولية الخاصة بجمع الأدلة على جرائم الحرب في سوريا (IIIM)، ولجنة التحقيق الدولية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاصة بسوريا (COI)، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) التي لديها برنامج خاص بسوريا. يتقاطع عمل هذه الجهات الدولية وغيرها مع المهمة المفترضة للآلية الدولية الجديدة المطلوبة، ويقول داني بعّاج إنه «لا يوجد تضارب بين اللجان الدولية ولا تعارض بين ولاياتها، فكل الولايات تكاملية، والفرق هنا أنّ الآلية التي يدعو البيان لإنشائها ستكون متخصصة بقضية المعتقلين والمختفين في سوريا بالتحديد. مثلاً، عندما أصدرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاصة بسوريا COI تقريراً وثقت فيه ضربات السلاح الكيميائي، لم يتعارض ذلك مع التقارير الفنية التي صدرت لاحقاً عبر لجان متخصصة تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW».
يقول داني بعّاج أيضاً إنه «سيكون هناك مباحثات بشأن الآلية وولايتها وصلاحياتها بين الدول، لكننا نأمل أن تستطيع هذه الآلية تقديم قوائم بأسماء المختفين قسراً والمعتقلين من أجل الوصول إلى معلومات عنهم، وأن تستطيع الوصول إلى نتائج حول مصير المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا. هذا الأمر يحتاج إلى أدوات، لذلك نحن نطالب بأدوات فنية تنفيذية عالية، مثل مختبرات للحمض النووي وتحقيقات للطب الشرعي وجمع عينات مع قدرة على متابعة المعلومات ومصير المعتقلين». ولكن هل يمكن فعلاً أن يكون عند هذه الآلية إمكانية الوصول إلى مواقع يُشتبه بأن تكون مقابر جماعية على سبيل المثال؟ يجيب بعّاج: «سيكون هذا عظيماً، لكن في توقّعي أننا سنعود لنصطدم بالعوائق التي واجهت عمل لجان التحقيق الدولية السابقة، إذ على الرغم من أنّ الولاية القانونية تسمح لتلك اللجان والآليات، بل وتطلب منهم، الوصول إلى أدلّة مادية على أرض الواقع، لكنهم لم يستطيعوا تنفيذ تلك التوصيات بسبب رفض النظام السوري السماح لهذه اللجان بالدخول إلى مناطق سيطرته».
لا طموحات كبيرة لدى أيّ من الموقعين بخصوص أن هذه الآلية ستنجح فيما عجزت عنه آليات ولجان سابقة، أي إجبار الأطراف صاحبة السلطة على التعاون، لأن هذا يتطلب إرادة سياسية دولية غائبة حتى الآن، وفي ظلّ غيابها فإنه لا يمكن إجبار النظام السوري، ولا حتى سلطات الأمر الواقع الأقلّ شأناً، على كشف مصير المفقودين والمُغيّبين أو تسهيل جمع معلومات بهذا الشأن. لكن يبقى أنهم يرون في إنشاء آلية أممية خاصة بالمفقودين والمختفين قسراً في سوريا خطوة ضرورية لاستدامة العمل، وتصعيد الضغط على كل الأطراف، وتقديم مزيدٍ من الدعم للعائلات في رحلتها للبحث عن مصير الأحباب.
الصور والفيديوهات والبحث عن المصير
كان واضحاً أن تكرار محنة الأهالي الذي يبحثون بأنفسهم في الصور والفيديوهات المسرّبة، كما هو الحال مع صور قيصر منذ تسريبها ومع فيديو التضامن الأخير، هو أحد الأسباب التي دفعت هذه المنظمات إلى إصدار بيانها الذي يجدد دعم مطلب إنشاء آلية دولية. وتوفّر منظمات وجِهات عديدة وسائل لمساعدة الأهالي، من بينها نموذج التبليغ عن مفقود على موقع رابطة عائلات قيصر، الذي يتضمن إمكانية رفع صور المفقودين للتحقق من وجودها بين الصور المسرّبة. وكذلك وسائل التواصل المُعلَن عنها على موقع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وآلية تحديد الضحايا في مجزرة التضامن التي أعلن عنها الباحثان أنصار شحود وأور أونغر بالتعاون مع الشرطة الدولية الألمانية. لكن لا يبدو أن هذه الوسائل كافية، بالتحديد لأنها ليست موحدة ولا شاملة.
يقول أحمد حلمي إن «غياب جهة واحدة محددة يلجأ إليها الأهالي للسؤال والبحث عن مصير أحبّتهم حمّلهم عبئاً ثقيلاً من خلال سؤال المفرج عنهم والبحث في الصور والفيديوهات، وهو أمرٌ منهكٌ ومؤلم. عند نشر المواد، تقوم العائلات بتصفح محتواها، فتتعرّضُ لألم تَخيُّلِ ما قد حدث لأحبّتها، والألمِ الناتجِ عن التعارض بين الخوف من وجود أحبّتها ضمن هذه المواد، وأمل وجودهم فيها لكي تتأكد من انتهاء معاناتهم في السجون وتعرف مصيرهم. عندما تقوم العائلات بتصفح المواد مراراً وتكراراً فهي تتعرض لصدمات بعدد الاشخاص الموجودين في هذه المواد، وحتى في حال وجود شبهٍ بين المفقود وأحد الموجودين في الصور، فإن عدم اليقين المؤلم يستمرّ لأن التطابق لا يكون تاماً. يجب إذاً أن توجد جهة مركزية موثوقة تعمل على تحليل الصور باستخدام التكنولوجيا وتُطابقها مع الصور الأصلية، ما يعيدنا إلى ضرورة وجود آلية مركزية تعمل تحديداً على كشف مصير المخفيين».
وتقول ياسمين المشعان إن «تسريب مقطع جريمة التضامن يشبه إلى حد كبير ما حصل معنا كأهالي تعرّفوا على أبنائهم ضمن صور قيصر، وقد أصدرت رابطة عائلات قيصر تقريراً تفصيلياً عن تأثير نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي على العائلات، وعن الجانب القانوني لهذا النشر. وبصرف النظر عن الجدل حول نشر صور الضحايا أو مقاطع الفيديو المسربة وضوابط ذلك القانونية والأخلاقية، فإن ظهور شبكات التواصل الاجتماعي غيّرَ قواعد وآليات الرقابة والتحكّم بشكلٍ كامل، فظهر ما يشبه الطفرة في انتشار الصور والتسجيلات المؤلمة التي تتضمن مشاهد تعذيب وقتل بصورة مستمرة، ما يُضاعف المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية التي يجب أن تحيط بالتعامل مع صور الضحايا في الحالة السورية والحالات المشابهة، والتي توجب على حائز صور الضحايا مسؤوليةً أخلاقية بأن يمتنع عن تحويلها إلى سلعة وعن تبديد معناها، وأن يساهم في الحفاظ على كيان موضوع الصورة من حيث هو “ضحية” لجريمة فيحيطها بكل أسباب الحفظ، و يصون حرمة موضوع الصورة وصولاً إلى تقديمها كدليل إثبات في محاكمة عادلة تتمتع بالمشروعية».
تتحدث ياسمين أيضاً عن ضرورة أن يتم التعامل مع الصور وفق فردانية صاحبها، لا أن يتم التعامل معها بالجملة، لأن خلف كل صورة قصة إنسان وعائلة فريدة، مضيفةً أن على الجهات التي تنشر الصور «أن تُراعي الطريقة التي سيتم من خلالها إخبار عائلات الضحايا ومشاركتهم الصور، لأن ما حدث من نشر غير منظمّ تسبَّبَ بالكثير من الآلام للعديد من الأسر والمقربين من الضحايا، وعلى هذه الجهات إبداء احترام أكبر لرغبة الأسر التي لا تريد نشر صور أبنائها».
تتفق مارية العبدة مع ضرورة عدم تداول هذه الفيديوهات والصور على وسائل التواصل الاجتماعي، «يجب عدم مشاركة هذه المواد، وعدم نشر معلومات غير مؤكدة 100%. كما أن على الجهات الحقوقية التي تعمل على معرفة الجناة أن تخصص جزءاً من مواردها للتنسيق والعمل على احتياجات الأهالي. من المهم جداً أن يكون الضحايا بالنسبة لنا كناشطين في الشأن العام هم الأولوية، وأن نستطيع تطوير نهج يتمحور حول احتياجاتهم، وحول احتياجات ذويهم لأنهم ضحايا أيضاً. إن مشاركة أي معلومات غير مؤكدة هي إساءة لهم، ولكن ثمة جانباً آخر يتعلّق بالقدر الذي نتعود فيه نحن كسوريين على العنف. عدم النشر هو موقفٌ يساهم في حمايتنا كبشر، وحماية إنسانيتنا من التوحش، لأن الوضع السوري والنظام السوري خَلَقا وحوشاً بسبب العنف الشديد».
ما الذي يمكن فعله أيضاً؟
يقول أحمد حلمي في حديثه مع الجمهورية إن «ملف المفقودين والمختفين قسراً من أعقد الملفات وأصعبها في أغلب السياقات التي عانت من الانتهاكات، وفي السياق السوري على وجه الخصوص نتيجة تعدد الجهات المنتهِكة واستخدامها أدوات متنوعة لمسح آثار الأشخاص المفقودين، ونتيجة تعقيدات كثيرة أخرى على رأسها وجود المجرمين والمنتهِكين على رأس السلطة». لذلك، يقول حلمي: «يجب أن يأخذ العمل على هذا الملف مسارات متعددة متوازية ومتقاطعة، وهذا ما وضعناه بشكل تفصيلي في ميثاق حقيقة وعدالة الذي يعكس رؤيتنا للتعامل مع هذه القضية على صعيدي العدالة قريبة الأمد والعدالة بعيدة الأمد، بحيث يتم تحصيل الحقوق والإنصاف والعدالة للمجتمع السوري عامة، والضحايا وذويهم خاصّة، بشكل تراكمي يؤدي للانتقال بسوريا تدريجياً إلى دولة قانون تحترم حقوق الإنسان».
يشرح حلمي أن هذا التفكير بالمسألة بوصفها عملية تراكمية، دفعهم إلى أن يضعوا على رأس أولوياتهم العمل على كشف مصير المخفيين قسراً ووقف التعذيب كـ «مطلبين مستقلّين منعزلين عن أيّ تقدم في العملية السياسية أو الانتقال السياسي وعمليات السلام في سوريا، بحيث لا يكون كشف المصير شأناً تفاوضياً أو ورقة يتم استخدامها في المحادثات السياسية». كذلك، يقول حلمي إن رؤيتهم تضع العمل على المحاسبة «شرطاً أساسياً لأي سلام حقيقي في سوريا، مع وعينا الكامل بأن المحاسبة مرتبطة بشكل وثيق بأن تُزاح عن المنتهكين الحصانةُ التي توفرها لهم السلطة والقوة التي يتمتعون بها حالياً».
وفي سياق التأكيد على أهمية فصل مطلب كشف المصير عن أي عملية تفاوضية سياسية، تقول مارية العبدة إن «معرفة الحقيقة بشأن مصير المختفين هي أولوية يتم التغاضي عنها أحياناً مقابل المحاسبة، ونحن لا نستطيع أن نلغي أي آلية من آليات العدالة مقابل أخرى، لكن علينا أن نتذكر أن هناك عائلات تضطر إلى تسجيل وفاة أبنائها المختفين قسراً في السجّلات الرسمية، من أجل استكمال إجراءات حياتهم القانونية مثل الإرث والحضانة».
يقول أحمد حلمي إن العقد الأخير أثبت لنا أن القانون والتشريعات الدولية غير كافية لضمان الحقوق، لكن نضالات شعوب أخرى تقول إنه «لا يموت حقّ وراءه مُطالِب، ولذلك فإن علينا كسوريين أن نستغلّ انتشارنا الواسع، وقدراتنا ومهاراتنا المختلفة وشبكاتنا، كي نُبقي الضجيج عالياً حول حقوقنا وقضايانا، وذلك للحفاظ على الزخم الذي يمكن استغلاله والبناء عليه حقوقياً بشكل استراتيجي فاعل. علينا أن نسعى إلى انتصارات صغيرة قابلة للتحقّق ويمكن البناء عليها، وأن نراكمها للوصول لعدالة شاملة في نهاية المطاف».
موقع الجمهورية
——————————
================




