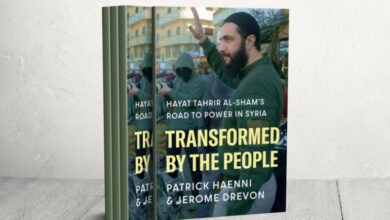الحرب تعود جزءاً ملازماً لبيئة العلاقات الدولية/ وضاح شرارة

اسم الكاتب: François Heisbourg
اسم الكتاب: Retour de la guerre
طُبع وصدر كتاب فرانسوا هيسبورغ، المستشار الخاص لمؤسسة البحث الاستراتيجي الفرنسية ورئيس المعهد الدولي اللندني للدراسات الاستراتيجية سابقاً، “عودة الحرب”، أو رجوعها، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عن دار أوديل جاكوب الباريسية. وكُتب، على الأرجح، في ربيع وصيف العام نفسه. وآخر واقعة يشير إليها الكاتب، وتأخرت عن كتابته، هي جلاء القوات الأميركية، المتوقع، عن الأراضي الأفغانية، عشية الذكرى العشرين لمهاجمة “القاعدة” برجيْ مركز التجارة العالمي بنيويورك وجناح البنتاغون في واشنطن.
وعلى هذا، فالحرب العائدة أو الراجعة ليست حرب روسيا على أوكرانيا، وليست على وجه التخصيص حرباً على الأرض الأوروبية التي لم تشهد حرباً “كبيرة” منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويصدق هذا التأريخ إذا أُغضي عن حرب كوسوفو وانفجار يوغوسلافيا في العقد العاشر، وعن قتلها 200 ألف إنسان معظمهم من المدنيين، وإذا نُسي الهجوم السوفياتي على تشيكوسلوفاكيا في صيف 1968، وسُهي عن هجوم سوفياتي سابق على بودابست المجرية في 1956، والهجومان خلّفا الآلاف من الضحايا، وغُفل عن حربي روسيا على جورجيا (2008) وأوكرانيا (2014).

وفي الأثناء، أي منذ الحرب العالمية الثانية إلى يومنا، فشت الحروب المتفرقة، حروب الدول، وحروب الأهل، والحروب الإقليمية، والحروب غير النظامية، والإرهاب، والأغلب حروب تخلط هذه الأصناف والأبواب على مقادير متفاوتة، في أرجاء الكوكب من غير كابح ولا حاجز تقريباً. فأين الجدّة في حرب أو حروب عائدة مطلع العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، إذا لم يقصد بها حرب أوروبية؟
يتناول “عودة الحرب” أمرين، على الخصوص، أشد هولاً من الجبهات العسكرية المتناثرة، ومن الحرب المشبوبة والمدمّرة التي تقودها موسكو على الشعب الأوكراني “الشقيق”، هما الحرب العالمية (الجائزة) بين القوتين العظميين، الولايات المتحدة الأميركية والصين “الشعبية”، أولاً، واجتماع عوامل متراكمة ومتضافرة، ناجمة عن أزمات واختلالات وابتكارات (تقنية)، مزمنة أو طارئة، يخلق اجتماعها وتضافرها بيئة تيسّر المبادرة إلى الحرب ولا تلجمها إذا هي اندلعت، وتعوق المفاوضة على السلم، ثانياً. والأمران يحتسبان، في ضوء حروب القرن العشرين، أحجام الحروب ومستوياتها، وأنماط تسلسلها وأطوارها في إصعادها نحو ذروتها المزدوجة والمروّعة، العالمية والنووية.
حادثة بحرية ضئيلة
ولعل ما يدعو المراقب إلى تقرير هذه العودة، ووصف الأعراض المؤذنة أو المرهصة بها، هو بعض الحوادث الطفيفة التي تدل على عدم تهيُّب الإقدام على أفعال تترتّب عليها، في السياق الذي تُرتكب فيه، عواقب غير محمودة، على أضعف تقدير، ويعلم مرتكبوها أنها قد تجر إلى خسائر فادحة. ويمثل فرانسوا هيسبورغ على مثل هذه الحوادث بالدقائق القليلة التي كاد الطرّاد التركي، “أوروش ريّس”، في 10 حزيران/ يونيو 2020، أن يطلق فيها النار على الفرقاطة الفرنسية “كوربيه”، حين اعترضت هذه طريقه، وأرادت تفتيشه في إطار عملية حلف الأطلسي “سي غارديان”، على الشواطئ الليبية، ومهمتها منع أعمال التهريب على أنواعها إلى ليبيا ومنها.
واقتربت الدولتان وهما حليفتان في منظمة واحدة، من حافة الاشتباك. وتتصل المناوشة بين “أوروش ريس” و”كوربيه” بالنزاع الليبي بين شرق البلد، وعلى رأسه خليفة حفتر، وبين غربه، وعلى رأسه (يومها) فايز السرّاج. وتؤيد روسيا، من طريق شركة “فاغنر” الأمنية، حفتر، بينما تحضن تركيا رئيس مجلس الدولة. وروسيا وتركيا يتنازعان، من غير اشتباك مباشر، السيطرة على شطر من سوريا. وكانا، في آخر فصل حربي بين أذربيجان وأرمينيا، على مسرح القوقاز، على طرفي القتال.
والحادثة، الضئيلة إذا أُفردت على حدة، تستدرج إلى معانٍ “كبيرة” حين تُدخل في شبكة حوادث أو عوامل مشابهة لها. فعلى شاكلة قريبة منها، تتعقب البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي، وفي الناحية الشرقية منه، سفن صيد البلدان المشاطئة، مثل فيتنام والفيليبين، أو سفناً حربية ترفع علم اليابان أو أستراليا أو الولايات المتحدة الأميركية، وتقترب منها على نحو يهدد سلامة الملاحة.
ويُعطف ذلك على استملاك بكين عنوة جزراً متنازعة في الدائرة البحرية، وعلى رفضها الاعتراف باتفاقات مشتركة وجماعية تنص على تقاسم حقوق متوازنة. وتقدّم عليها اتفاقات ثنائية، تفرّق صفوف المفاوضين، وتحرّض بعضهم على بعضهم الآخر، وتثير المنافسة بينهم.
السلاح الديمقراطي
ومن جهة أخرى، بعيدة من المقارنة بين الصين وتركيا، اضطلعت المسيّرات التركية بدور راجح في الحرب الأذرية-الأرمينية. ويذهب هيسبورغ إلى أن المسيّرات، شأن الاتصالات الخلوية والشبكات السيبرانية، ذات أثر قوي في تقليص تكلفة الحرب، والمساواة بين الدول، وقواتها العسكرية الثقيلة التجهيز، وبين الجماعات المحاربة والمتنقلة من ملجأ إلى ملجأ.
ويترتب على الهجمات السيبرانية، وعُسر تعيين مصدرها، وعلى مفاعيلها الباهظة في أحيان كثيرة، تضييق الفرق بين الحرب والسلم وتوسيع المنطقة الرمادية بين الحدّين. فتكثر الشبهات السياسية والجنائية ومعها الدواعي إلى الظن في مقاصد من قد لا يكونون، ظاهراً، خصوماً.
ولا شك في أن انخراط كيانات سياسية مختلفة، ومتفاوتة الصفة، تترجّح بين الحلف الدولي والدولة الإقليمية وبين الفريق المحلي وجزء أهلي من بلد متداعٍ و”فاشل”، في كتلة واحدة، يضيّع معالم المساءلة والتعارف القانونيين. فالبحرية التركية التي ترابط على الشاطئ الليبي، وتتذرّع بتعاملها مع دولة ذات سيادة، وقّعت معها معاهدات “بين دولة ودولة”، إنما ترعى جزءاً من أهالي البلد وجماعاته وأحزابه، وميليشياته، ومرتزقته. ولا تثبت أحوال هذا الجزء على تماسك مضطرب إلا بعض الوقت، وفي ظروف متغيّرة، داخلية وخارجية، ولقاء أثمانٍ بعضها غير مشروع.
وعلى هذا، قد ينقلب التزام البحرية التركية النظامية الدفاع عن حق سيادي ودولي يقرّ لها بالحصانة من التفتيش المتعسّف، إلى الضلوع في قرصنة مبتذلة، والتستّر على عملية تهريب عادية وسائرة. فالخليط المتفاوت والمختلف الذي يعقد بين كيانات متباينة الأحوال والأوضاع “يخلط” بدوره صفة الأفعال الصادرة عن الأطراف والكيانات، ويجر الفعل والطرف إلى قتال مشتبه.
العولمة الملجومة
ولا تستقيم دلالات الملاحظات الجزئية والمبعثرة إلا بحملها على اتجاهات وأطوار “مزمنة”، طويلة الأمد الزمني، وعمومية التظاهر. فعودة الحرب، على معنى شيوع الشروط التي تيسّر تصوّرها وقبول جوازها أو احتمالها، ومباشرتها أو الوقوع فيها، وَجه من وجوه انحسار العولمة أو انقباضها وانكفائها النسبيّين. فمنذ أزمة 2008- 2009 المالية والاقتصادية تأخر تنامي المبادلات الدولية السلعية (وليس المالية والمصرفية) عن نمو الاقتصاد العالمي، واصطدم انتقال البشر بمعوقات وحواجز طارئة، وذلك من الحدود الأميركية-المكسيكية إلى حوض المتوسط.
وعمدت الصين إلى تشييد “سور (رقمي) عظيم” سوّرت به تدفّق المعلومات والبيانات. ورفع الاتحاد الأوروبي دوائر حماية حول المعطيات التي تتعلق بخصوصيات الأفراد. وأولت روسيا اهتمامها فك فضائها الرقمي من الشبكة العنكبوتية العالمية، وعزله عنها. وأقدمت ديكتاتوريات موصوفة، وبعض الديمقراطيات، على حظر الولوج إلى الشبكة، في أثناء الاضطرابات الداخلية أو تلافياً لأخطار إرهابية، مفترضة أو حقيقية. وتهدّدت البلقنة أو التجزئة الإنترنت، عنوان العولمة الأول والأبرز.
وتعثّرت الولايات المتحدة الأميركية، وهي محور النظام الاقتصادي والاستراتيجي العالمي، وراعيته وضمانته، وزلّت قدمها منذ اجتياح جورج دبليو بوش العراق، وحملته البائسة عليه. وعظّم العثرة إحجام باراك أوباما عن الاضطلاع بدور الريادة الأميركية عام 2013 في سوريا. وعلى خطاه سار دونالد ترامب. وقد لا يفلح جو بايدن في تصويب المسار، بينما تمضي الصين على توسيع دورها.
وأدّت جائحة “كوفيد-19” إلى تعميق هذه الاتجاهات. وثبّتتها الأزمة الاقتصادية القاسية التي كبحت العولمة وأصابتها في مواضع شديدة الحساسية. فغذت انكفاء البلدان والمجتمعات على نفسها، وأذكت المنافسة بينها. وبدلاً من عقد الأيدي، واجتماعها على معالجة الأزمة الصحية، شهد العالم تفرّق الجهود، وانفضاضها عن الغرض المشترك، وانصراف كل طرف إلى علاج شاغله ومشكلته في معزل عن غيره.
ولا يؤذن هذا بتضافر الجهود على التصدّي لما يفوق جوائح فيروسية كثيرة خطراً، وهو التغيُّر المناخي المتعاظم. فالصين، وهي البلد الي تدنّت خسارته من الجائحة عن خسائر غيره على رغم أنه حضنها الأول، تخرج على النظام الليبرالي والديمقراطي الذي ازدهرت في كنفه، وتدين له ولقواعده بـ”إقلاعها”، ومواردها التكنولوجية، وبعض أسواقها. وتصاحبها في خروجها روسيا المستميتة في طلب ثأرها لانهيار الاتحاد السوفياتي.
وكلا البلدين يقصّر تقصيراً فادحاً عن رسم خطوط علاقات دولية في إطار مجتمع دولي لا تسوده فوضى مدمّرة، أو يستوي على شاكلة النظام الذي صنعه الاتحاد السوفياتي في أثناء الحرب الباردة. وفوضى عالمنا اليوم لا تشبه الحرب الباردة، واستقرارها الغريب، ولا تُنذر باندلاع الحرب حتماً جراء خوف القوى الغالبة والراسخة من منافسة قوى جديدة ناشئة، على مثال ينسب إلى توقيديدس (توسيديد) اليوناني، الذي أرّخ لحروب المدن اليونانية تحت لواءي أثينا وإسبارطة (431 ق.م.- 404).
أينما توجّهتم…
ولعل الشّبه الأقرب بين صورة عالمنا وبين صورة سابقة للعلاقات الدولية، ومحل الحرب منها، هو بألمانيا الغليومية (غليوم أو فيلهلم الثاني، قيصر الإمبراطورية 1888- 1918)، وبروزها على المسرح الدولي في عقد 1890. أو الشبه بعقد 1929- 1939، وفي أثنائه عجزت القوة المهيمنة الآفلة، أي الإمبراطورية البريطانية، عن الاضطلاع بضبط العالم، أو رفضت الاضطلاع بالضبط، بينما لم تكتمل شروط القيام بالمهمة للقوة الأميركية الخالفة. وفي كلتا الحالين، كانت الحرب العالمية على الموعد.
وفي هذا الوقت، لم تكفّ الأسلحة المتجددة عن الاصطباغ بصبغة عمومية، أو ديمقراطية، ولم تكفّ دوائر استعمالها عن الاتساع والانتشار، على ما تقدّم القول. وبين الحرب السيبرانية والمعلوماتية اليومية، وهي قليلاً ما تقتل، وبين الكارثة النووية، وتهديد طيفها الماثل والمقيم على طيفيته وافتراضيته لحسن الحظ، فقدت الفروق بين ما هو حرب وما ليس بحرب جلاءها ووضوحها السابقين. إلا أن “المناطق الرمادية” و”النزاعات غير المرئية” و”الحروب الهجينة” غالباً ما تمهّد الطريق إلى حروب صريحة، وتتعدّى المراحل الوسيطة إلى هذه النهايات.
وفي عالم من غير نظام أو ترتيب يضبطه، تغلب “تجربة” (على معنى الصلاة: “نجّنا من التجربة”) النازع إلى استعمال القوة في موضعين: على أبواب أوروبا وفي مركز العالم الاقتصادي والاستراتيجي، أي منطقة الهند- المحيط الهادئ. ويترجّح هذا الاستعمال، على ما سبق القول كذلك، بين مستوى الجماعات والعصابات غير النظامية وبين الدول العظمى.
وفي خضمّ هذا الاضطراب يعوّل بعض الدول الأوروبية على الحماية الأميركية، في وقت تترنّح الثقة في هذه الحماية، وتتردّد الولايات المتحدة في ضمانها، وتقدم مواجهة ارتقاء الصين إلى مرتبة القوة العظمى على غيرها من المشاغل. ويلوح في شرق أوروبا خطر روسيا الداهم. ودول شرق أوروبا على دراية تامة به، ويكاد ينسيها مصادر التهديد الأخرى.
فأينما توجّهت مجتمعات عالم اليوم مَثَلَ أفق الحرب. ولا تشذ أوروبا عن سواد العالم، على خلاف حالها، وإنْ نسبياً، في العقود الثمانية المنصرمة. وهي التي يدعوها هيسبورغ إلى دمج ديون دولها، وتوزيع تسديدها على قدم المساواة بين دولها الشمالية الغنية ودول جنوبها الأقل ثراءً وتزمتاً مالياً. ويحضّها على التخلّي عن هذا التزمُّت، وانتهاج سياسة إرادوية مشتركة، من نتائجها المحتملة لجم نازع بعض جيرانها إلى الحرب.
رصيف 22