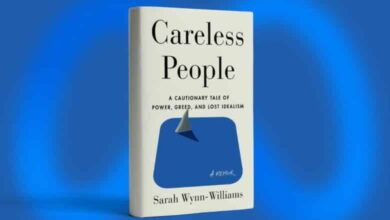ما يجب أن تعرفه عن السلطوية/ عمر كوش

الإشكالية التي تنطلق منها إريكا فرانتز، مؤلفة كتاب “السلطوية .. ما يجب أن نعرفه” (الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ترجمة حمزة عامر، 2022)، أن معظمنا يمتلك في ذهنه صورة نمطية عن النظام السلطوي، تتلخص بأنه قمعي ذو طبيعة وحشية، تتركز سلطاته في يد شخص واحد، ويتفرد بسلوكياتٍ غريبة، وهو وصف دقيق في بعض الحالات، حيث إن بعض الأنظمة السلطوية تتلاءم مع هذه الصورة النمطية، لكن بعضها الآخر يناقضها. وبالتالي، غاية الكتاب تقديم فهم أوضح للسياسات والأنظمة السلطوية، وتقديم إجابات عما يطرح من أسئلة عن السلطوية، بالاستناد إلى الدراسات النظرية والتطبيقية. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب في إضاءة السياقات السياسية التي تدور داخل الأنظمة السلطوية، عبر تقديم دراسةٍ مبنيةٍ على إحصاءات وبيانات عنها، خصوصا أنها تُعرف بصعوبة فهمها ودراستها، نظراً إلى أن السياسة الداخلية التي تحكم الأنظمة السلطوية مخفيةٌ غالباً عن الناس في ظلّ فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام أيضاً، ويصعُب أيضاً إيجاد بياناتٍ يمكن التعويل عليها مع الانتشار الغزير لبروباغندا الأنظمة السلطوية.
ويدخل الكتاب في إطار التوسّع والتغيّر الذي عرفته، في السنوات الأخيرة، الدراسات والأبحاث التي تتناول الأنظمة والسياسات السلطوية بصورة أساسية، وذلك مع تغير النزعة التاريخية في العلوم الاجتماعية، التي كانت تولي الاهتمام بالأنظمة الديمقراطية على حساب إهمال السلطوية، إدراكاً من الباحثين والدارسين أن الأنظمة السلطوية باقية وتتمدّد، فأكثر من ثلث الدول اليوم تحكمها أنظمة سلطوية، وليس هناك ما يدلّ أو ما يشير إلى أفولها أو انحدارها.
وتحدّد المؤلفة النظام بأنه مجموعة من القواعد الرئيسة، الرسمية وغير الرسمية، التي تحدّد من له أن يؤثر في خيارات الحكام والسياسات، بما في ذلك القواعد التي تحدّد الدائرة التي يُختار منها الحكام، ويكون النظام سلطوياً متى ما انتزعت الذراع التنفيذية فيه السلطة بطرائق غير ديمقراطية، أي بطرقٍ غير الانتخابات الحرّة والنزيهة (مثل كوبا في عهد الأخوين كاسترو أو سورية في عهد الأسدين، الأب والابن)، أو إذا وصلت الذراع التنفيذية بانتخابات حرّة ونزيهة، ولكن بعد ذلك قامت بتغيير القواعد، بما يفرض قيوداً على أي منافساتٍ انتخابية آتية، سواء تشريعية أم تنفيذية (مثلما حصل في كينيا في عام 1963 وزامبيا عام 1996 وتركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية عام 2002). وعليه، يضع الكتاب وجود انتخابات حرّة ونزيهة معيارا تتمايز فيه الأنظمة السلطوية عن غير السلطوية، بوصفه معياراً يحدّد مسار وصول الحكومة إلى السلطة.
وعند البحث في جذور الأنظمة السلطوية، نعثر على آثارها قبل آلاف السنين، بدءاً من فراعنة مصر القديمة وصولاً إلى أباطرة روما وممالك أوروبا وسلطاتها المطلقة، ولكن الأنظمة السلطوية في عصرنا الراهن تطورت تطوّراً كبيراً عن أسلافها، حيث قامت السلطوية القديمة على ملك أو حاكم يتفرد بالسلطة، ولم تحاول تلك الأنظمة إخفاء سلطويتها أو التستّر عليها، ثم تغير وجه الأنظمة السلطوية بالتزامن مع التطورات العالمية التي حملها القرن العشرين المنصرم، فظهر مفهوم حكم الأقلية أو الأوليغارشية، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ظهر مفهوم الأنظمة الشمولية، كألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي، حيث اعتبرت حنا أرندت الأنظمة الشمولية شكلاً استثنائياً جداً من الأنظمة السلطوية، تتمتع فيه السلطة بسيطرة كاملة على أفراد مشرذمين ومعزولين، ثم بدأت أسهم الشمولية بالانخفاض، مع تشكّل أنظمة ديكتاتورية، ولكنها لم توافق النموذج الشمولي، مثل نظام فرانكو في إسبانيا والديكتاتوريات العسكرية في أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.
وتركز المؤلفة جهدها البحثي عن السلطوية وأنظمتها في هذا الكتاب على الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى عصرنا، أي على السلطوية المعاصرة، ولا تميل إلى التفريق بين استخدام مصطلحات الأنظمة السلطوية والديكتاتورية والأوتوقراطية، بل تستخدمها في السياق نفسه، لكنها تميّز بين أشكال الأنظمة السلطوية، خصوصا أن معظم الأنظمة الديكتاتورية المعاصرة أنشأت مؤسساتٍ ترتدي عباءة الديمقراطية، كأحزاب سياسية وهيئات تشريعية وانتخابات تشارك فيها أحزاب، لكي تعينها على البقاء في السلطة، فظهرت “أنظمة سلطوية هجينة” أو “أنظمة المساحة الرمادية”، أو “أنظمة سلطوية انتخابية”.
ويجري تناول السياسات السلطوية من جهة تبيان أهم الفاعلين في أنظمتها، وتحديد ميولهم واهتماماتهم، بالنظر إلى أن السياسة السلطوية تتمركز حول تشعبات العلاقات بين الحاكم والنخبة والجماهير، حيث يدخل الحاكم والنخبة في حالة مستمرّة من الصراع على السلطة المتجذّرة في رغبة كل منهما انتزاع نفوذ سياسي أكبر مع عملهم، في الوقت نفسه، على كسب قطاعات هامة من الجمهور. غير أن شكل هذا الصراع ومآلاته السياسية اللاحقة تحدّدها بيئات المؤسسات السلطوية، لذلك يجري التركيز على أهمية التمييز بين الحكام السلطويين والأنظمة السلطوية على مستوى تحليل كل منهما، بالرغم من وجود حالاتٍ لا يمكن فيها الفصل بين الحاكم والنظام، ولكن هناك حالات أخرى كثيرة يبقى النظام فيها قائماً بعد حقبة حاكمٍ ما، يضاف إلى ذلك أن الأنظمة السلطوية تختلف خلال الحقبات السلطوية، ويمكن أن يتناول عددا من الأنظمة السلطوية خلال حقبة واحدة، ومثال ذلك نيكاراغوا التي بقيت تحت حكم السلطوية بين عامي 1936 و1990، إلا أنها عاصرت نظامين سلطويين مختلفين، تجسّداً في نظام عائلة وموزا من 1936 إلى 1979، وبعده النظام “السانديني” (نسبة إلى الجبهة الساندينية) حتى عام 1990، بينما لم يعرف العراق سوى الحكم السلطوي منذ عام 1932، حيث تعاقبت على حكمه ستة أنظمة سلطوية مختلفة وعشرة حكام سلطويين مختلفين. وبالتالي، لم يفض التدخل الأميركي الخارجي الذي أطاح النظام السلطوي في العراق إلى قيام نظام ديمقراطي بدلاً منه، بل على العكس، تمّ الرجوع إلى نظام سلطوي، بُني على العصبيات الطائفية والعلاقات العائلية والعشائرية، وإنْ بشخصياتٍ وأحزابٍ ومؤسساتٍ وعلاقاتٍ جديدة، والأمر نفسه ينسحب على معظم الحالات التي جرى فيها إسقاط الأنظمة السلطوية بتدخل أجنبي.
وتلقي مؤلفة الكتاب نظرة عامة على تغيرات مشهد الحكم السلطوي في العالم، كي تبيّن الدول والمناطق التي ظهرت فيها الأنظمة السلطوية تاريخياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والتغيرات التي طرأت عليها، من خلال توصيف العلاقة بين الظروف الاقتصادية ونوعية النظام السياسي، التي تظهر أن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية يلازمان بعضهما، فالدول الغنية أشد ميلا إلى إقامة نظام ديمقراطي، على عكس الدول الفقيرة التي تغلب فيها السلطوية، لكن ذلك لا يمنع وجود استثناءات، إذ حافظت الأنظمة الغنية في البلدان العربية على سلطويتها منذ نشأتها. لذلك لا يبدو أن ثمّة مستقبلاً أفضل ينتظر الدول العربية، خصوصاً عند مقارنتها بما حدث بعد انهيار دول المنظومة الشيوعية وسقوط الاتحاد السوفييتي، حيث جرى تغيير أنظمة ديكتاتورية كثيرة في منطقة وسط أوروبا وشرقها، فيما بقيت أغلب الأنظمة العربية السلطوية خارج موجة الانتفاضات والثورات التي حدثت مع نهاية عام 2010 وبداية عام 2011، ولم يُفض سقوط الحاكم في الأنظمة السلطوية العربية إلى قيام أنظمة ديمقراطية فيها، بل أجهضت ثورات ما عرف بالربيع العربي. وفي المحصلة، تتركز معظم الأنظمة السلطوية في العالم اليوم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا والعالم العربي، ولا يوجد حتى 2014 سوى أربعة أنظمة سلطوية حاكمة في العالم من خارج هذه الأقاليم الثلاثة، نظامان سلطويان في أوروبا، روسيا وبيلاروسيا، ونظامان في أميركا اللاتينية، كوبا وفنزويلا.
وتركز المؤلفة على أهم الاستراتيجيات التي يعمل بها حكام الأنظمة السلطوية لصون هيمنتهم، فجميع رؤوس الأنظمة السلطوية يجمعهم هدف البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، أو “إلى الأبد” بحسب نظام الاستبداد الأسدي في سورية. وعليه، يسعى حكام هذه الأنظمة إلى توطيد سيطرتهم على كل ما يمكن من أدوات سياسية خلال فترة حكمهم، مثل المناصب العليا العامة، وصناعة السياسات والقوى والأجهزة الأمنية، ونجح بعضهم في تحقيق مسعاهم بالسيطرة على كل مفاصل الدولة، مثل حافظ الأسد وابنه بشار في سورية وعيدي أمين في أوغندا، ولكن بعضهم الأخر فشل في ذلك، مثل أحمدي نجاد في إيران.
وباعتبار أن الحكام السلطويين يعيشون تحت هاجس تهديد دائم بخسارة العرش، ويتجلى في النخب التي تتربّص باستمرار فرصة لانتزاع بساط الحكم من تحت أقدام الحاكم، فضلاً عن الاضطرابات والاحتجاجات التي يمكن أن تتحوّل إلى انتفاضات وثورات شعبية، لذا تتصدّر مسألة الحفاظ على السلطة من التصدّع أولويات سياسات الحاكم السلطوي، التي يقدم فيها مسألة تحييد تهديد النخب على تحييد تهديد الشعب، لأن احتمال إطاحة النخب الحاكم أكبر من فرصة إسقاط الشعب له. وعليه، يستخدم الحكام تكتيكاتٍ مختلفة لتقليص خطر النخب المفضي إلى تقليص فرص إسقاطهم من الحكم، لذلك يحاولون منع حدوث أي انشقاقٍ للنخب من دائرة الحكم، ومنع قيام أي تحالفٍ للنخب، تمهيداً لانشقاقها. كما أن الحكام لا يغفلون عن الانقلابات العسكرية التي تعتبر الوسيلة الأكثر شيوعاً لفقدان الحكام السلطويين عروشهم. لذلك يسعى الحكام السلطويون إلى تأمين أنفسهم من الانقلابات العسكرية، وذلك باتباع سلوكيات تركّز في معظمها على عملية الشخصنة التي تفضي إلى تركيز السلطة في يد الحاكم الفرد، والتي تترك تبعاتٍ على سياقات عديدة. أما سيناريوهات ترك الحكام السلطة فهي مختلفة، حيث ينعم بعضهم بحياة مريحة بعد تركهم السلطة وفق صفقات عقدوها، في حين لاقى بعضهم الآخر مصيراً مشؤوماً، خصوصا وأن معظم الديكتاتوريين يتمسّكون بالسلطة، حتى وإن كان ذلك على حساب قتل الشعب وتخريب البلاد مثلما حصل في سورية، إذ أن نظام الأسد الديكتاتوري ما أن شعر بأن كرسي السلطة قد اهتزّ من تحته، بفضل الحراك الاحتجاجي السلمي الذي بدأ في سوريه منتصف مارس/ آذار 2011، حتى بادر إلى استقدام المليشيات الإيرانية ومليشيات حزب الله، وإلى إشعال حرب أهلية، وذلك من أجل وأد الثورة والبقاء في السلطة إلى الأبد، وقد فعل كل شيء قذر تنفيذاً لشعاره “الأسد أو نحرق البلد”.
وتظهر الأبحاث سبع طرق تصل بها الأنظمة السلطوية إلى الحكم، وهي استيلاء عائلة على الحكم، والانقلاب العسكري، والتمرد، والانتفاضة الشعبية، و”التسلط” (تغيّر النظام نفسه)، وتغيير القواعد بما يغير تركيبة الكتلة الحاكمة، وتنصيب نظام سلطوي على يد قوة خارجية. كما تظهر أن الانقلابات العسكرية، التي يقوم بها ضباط في الجيش، هي أكثر طريقة استخدمتها الكتل الأوتوقراطية للوصول إلى الحكم وإقامة أنظمة أوتوقراطية، مثل انقلاب عام 1963 في سورية، الذي أفضى إلى انقلاب 1970 وقيام ديكتاتورية آل الأسد، والانقلابات الأخرى التي حدثت في كل من مصر والعراق واليمن وتشيلي وكمبوديا وأفغانستان وبوروندي والكونغو وسواها. إضافة إلى وجود حالاتٍ لأنظمة ديكتاتورية تصل إلى السلطة أيضاً عندما تدعم قوى الاحتلال والقوى الأجنبية حاكماً غير منتخب أو عندما تغيّر الأحزاب المنتخبة القواعد لمنع إجراء انتخابات حرّة، أو عندما تخرج، بشكل مباشر، من الحركات والانتفاضات الشعبية، مثلما حصل في ثورة إيران عام 1979 التي أعقبها قيام نظام ثيوقراطي، وحصل كذلك في الانتفاضات التي عمّت أرمينيا عام 1998، وتبعها وصول روبرت كوتشاريان إلى منصب رئاسة أرمينيا.
وفي الختام، تذكر المؤلفة أن الأنظمة السلطوية لن تختفي قريباً، وأن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة سلطوية، بما يعني أن ثلث دول العالم تحكمها أنظمة سلطوية، وهو ما يعدّ انخفاضاً في عددها، مقارنة بعددها خلال حقبة الحرب الباردة، وهناك بعض المؤشّرات التي تدل على استمرار انخفاض عددها. ولكن المهم بالنسبة إلينا في المنطقة العربية أن يساعدنا الكتاب على فهم السياقات السياسية في هذه الأنظمة التي تحكم بلداننا.
العربي الجديد