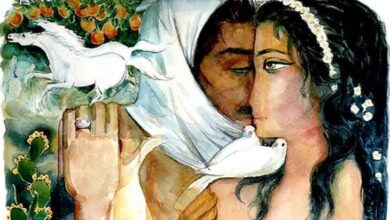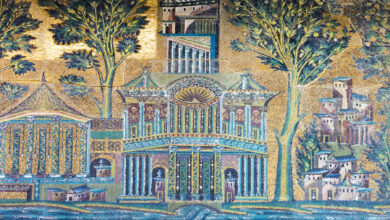اليوميات أو دفاتر الحساب والموت/ كمال الرياحي
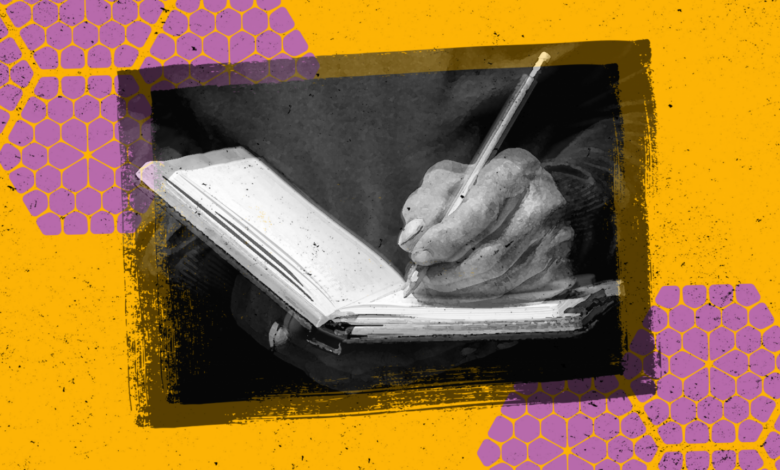
اليوميات أو دفاتر الحساب والموت I
كان هناك دفتر صغير لا يفارق جيب أبي، يسميه “الزمام”، وكان يقيّد فيه كل ما تعلّق بحياتنا والأرض وبقطيع العنز الذي يملكه: من مواعيد ضراب وولادة، ومواعيد الحصاد وتواريخ الزراعة، وفيه كان يحدد أضحية العيد وأسعار العلف وعدد أحزمة التبن ومواعيد تقليع شجر السدر وتنقية الأرض من الأشواك وزبر الزيتون، وفيه كان يعيد مراجعة ديونه، مداخيله ومصاريف دخولنا للمدارس واشتراكات الحافلة المدرسية، ميزانية اللباس الجديد وأثمان الكتب والكراسات والأقلام، تواريخ الأعياد والعطل ومواعيد جزّ الخرفان وتلقيح الكلب.
كان أبي يحكم إخفاء ذلك الدفتر في جيب سترته الداخلي مشدوداً بخيط، مثله مثل ساعة الجيب، حتى لا يقع في يد أحد غيره، فلا نكاد نراه إلا متى استلّه ليكتب فيه، ولذلك لم يشدني الفضول لشيء غيره إثر وفاته، في جلسات توزيع ميراثه القليل بيننا نحن أولاده وبناته.
ظللت أقلّبه وأتحسّس خط أبي وأحاول فك رموزه، ومن حرصي عليه صرت بدوري أخفيه كل مرة حتى أضعته.
وظل ذلك الدفتر الضائع في ذهني إلى اليوم وأنا أتذكر تلك الرموز والصور والخربشات والجداول التي لم أنجح في فكها وقتها، حتى قرأت دراسة منذ سنوات قليلة تتحدث عن ارتباط فن اليوميات في نشأته بالحساب، فقد ظهر عند التجار الذين يجردون آخر اليوم مبيعاتهم وأرباحهم، ويحصون مداخيلهم في دفاتر سرية يحكمون اخفاءها في درج من أدراج خزائنهم أو مكاتبهم، فتذكرت أن أبي بدوره قد مارس التجارة قبل أن يعتزل، بعد فشل ما يسمى بتجربة “التعاضد” سنة 1969 التي قادها الوزير أحمد بن صالح.
ويبدو أن عادة استخدام ذلك الدفتر هو كل ما جناه من تلك التجربة، بعد أن عاد للعمل بالفلاحة وتربية الماشية بدل إدارة محلات البقالة المشتركة مع تاجر من جزيرة جربة.
دفتر والدي والأرقام والكفن
كان دفتر والدي مليئاً بالأرقام وقليل من الكلمات، مثل كلمات مفاتيح، مرة بالعربية القرآنية ومرة بالفرنسية. ذلك الكم الكبير من الأرقام نفّرني في البداية، ثم تحوّل إلى مبعث متعة كبيرة، بعد أن تمكّنت من حل أولى شفراته فيما يتعلق بتاريخ لقاح العنز، وتاريخ آخر وضعه أبي كتوقع لموعد ولادتها. كان شيئاً ممتعاً وأنا أتتبع ذلك التاريخ وأثبت صحته بعد ذلك عندما ولدت العنز.
هذه الأرقام إذن ليست مجرد أرقام جوفاء، بل فيها شحنة من التخمين والتوقع ومن الحياة اليومية، من الممكن ومن المستقبل ومن عصارة التجربة الحياتية، كانت تتخللها خربشات ورسوم تعكس حيرة والدي وربما مشاعره.
كان كتاب أبي كأنه كتاب مقدس، فيه أيضاً تنبؤاته وحساباته المحزنة، ففي آخر الدفتر كتب، فيما يشبه الوصية، جملاً قليلة، يخبرنا فيها أنه وضع مبلغاً من المال في جيب سري بحافظة الأوراق، استبعده احتياطاً لكي نشتري به كفنه إذا ما مات ووجدنا حقيبة نقوده فارغة.
هكذا بدا لي أن أبي بذلك الدفتر قد ترك لنا كتاباً مهنياً مشفّراً نسير عليه، ودرساً روحياً في آخر الدفتر، يقول إن كل الحسابات الدنيوية لا يجب أن تنسينا أن الموت حق، وأن علينا أن نتدبر أمر رحيلنا من هذا العالم بكرامة وكبرياء.
وأكد لي ذلك الدفتر أن دفتر اليوميات يجمع بين التأريخ للحياة، في ظل وعي تام بحتمية الموت كواقعة ثابتة.
تحولات دفاتر الحسابات
يقول الناقد الفرنسي فيليب لوجون متحدثاً عن نشأة اليوميات: “اليوميات ولدت، كالكتابة نفسها، من الحاجة للتجارة والإدارة، فعندما نمارس التجارة، من الضروري ترك أثر للتبادلات، ولمعرفة وضعية المخزون، لذلك نسجلها بالتاريخ”.
ثم انتقلت عادة “مسك” الدفاتر الخاصة، إلى التجار الرحالة فخطوا فيها ملاحظاتهم واكتشافاتهم وأحوال الأرض وأحوالهم الخاصة، فصارت كتب الرحلات والجغرافيين، ومنها ظهر أدب الرحلة و كورديلو المسافر، بينما تطورت الظاهرة في المدن عند العامة، لتصبح دفاتر خاصة انتشرت عند المراهقين، وخاصة النساء، حيث فضاء التحريم شاسع، سيّجته الأخلاق والدين والعادات، فكان ما يعرف بـ “دفاتر الوسائد”، وصار الدفتر الصديق الحميم، المخلص، الذي يؤتمن على أسرار الفتيات، وتحولت الأسرار، من أسرار المال إلى أسرار العواطف والأجساد.
عندما خرج الرجل ليقاتل، حمل معه دفتره الحميم ليسجل فيه أهوال الحرب والنفس وما عانت، فكانت يوميات الحروب، وكذلك فعلت النساء اللواتي التحقن كمقاتلات أو كممرضات ومسعفات للجرحى، وحتى اللواتي بقين في الملاجئ استللن دفاترهن ليدوّن حياتهن هناك، في المخابئ وفي معسكرات الحشود.
وعندما سقط بعضهم في الأسر والاعتقال، كانت دفاتر اليوميات رفيقة السجناء والمعتقلين والأسرى، فقدت من الأوراق المتفرقة ومن جوانب صفحات الصحف ومن أغلفة علب السجائر.
وظل هذا الطابع الاحصائي والرياضي قائماً في كل اليوميات، القديمة منها والمعاصرة، وظل ذلك النفس الحسابي ثابتاً في كل جلوس إلى الدفتر لمحاسبة اليوم؛ محاسبة الزمن.
اليوميات ومطاردة الزمن
تعتبر الكتابة الأوتوبيوغرافية، واليوميات تحديداً، جنساً كتابياً زمنياً من الطراز الأول، فهو متجذر في الزمن، ولا يمكن التدليل عليه من خارجه، بل عليه في الغالب أن يعلن عن زمنيته من بدايته، لذلك يحرص بعض كتاب اليوميات على تحديد الفترة الزمنية التي تعتني بها اليوميات تحت العنوان.
فاليوميات هي فن إدارة الزمن بامتياز، بل إن هوية الشخص الذي يمارسها مستمدة من هذه الزمنية: فنطلق عليه في الإنجليزية لقب Diarist، وعنها أخذت لغات أخرى، والعبارة مشتقة من اليوم والطابع اليومياتي للممارسة، لذلك احتفظت به الفرنسية من اللغة الإنجليزية، لأن الصحافة استولت مبكراً على عبارة “جورناليست”، كما يقول فيليب لوجون، ولا يمكن تمييز عبارة “جورنال” بمعنى اليوميات، من “جورنال” بمعنى الصحيفة، إلا بزيادة عبارة “خاصة”، لأن الفرنسية “ليس فيها أي كلمة يمكن أن تشير للشخص الذي يسجّل يومياته”.
أما في العربية لندرة هذا النشاط لم ينحت له مصطلح، وظل النقاد يستعملون في الغالب عبارة مركبة “كاتب اليوميات”، مع أن الكتابة ليست شرطاً أساسيا لممارسة هذا الفن، ولم يجرؤ ناقد إلى حد هذا اليوم على اجتراح مصطلح يفي بهوية هذا الفاعل كـ “اليومياتي” مثلاً.
اليوميات: أرقام وتواريخ
لا يمكن الحديث عن اليوميات إلا متى توفرت سلسلة من الأرقام تعكس تواريخ الأيام التي تجري تحتها الأحداث والأفكار، وهي في النهاية كما يقول صاحب “شاشتي العزيزة”: “قائمة بالأيام”، فاليومية تدخل جنسها بداية من شكلها، وغياب التاريخ العددي يسقط عنها هويتها الخاصة باعتبارها يومية، تقول بياتريس ديدياي: “كاتب اليوميات يحرص على تعيين الوقت الذي يمارس فيه الكتابة: بل إن هذا التعيين للتاريخ هو الذي يمكّن، في النهاية، من الحديث عن )يوميات)، وهو ما من شأنه أن يميزها من دفتر الأفكار”.
وتذكر القواميس والموسوعات أن اليوميات انحدرت من عالم الرزنامة أو التقويم و”الرُزْنامَة أو الرُوزْنامَة أو المُفَكّرَة، هي جهاز أو أداة مادية (كُتيَّبٌ ورقى، دفتر أو يومية حائط ورقية في كثير من الأحيان) تستخدم لتحديد التواريخ أو التذكير بها، والتاريخ هو يوم واحد معين ومحدد، ضمن هذا النظام للعد الزمنى، ويعرفها المعجم الوسيط بـ “كُتَيِّب يتضمن معرفة الأيّام والشهور وأوقات طلوع الشمس والقمر على مدار السنة، وهي دفتر يستعمل في إدارة صرف مرتبات أرباب المعاشات العاملين في إدارة أو مؤسسة”.
وقادني البحث في كلمة “الزمام”، ذلك الاسم الذي أطلقه أبي على دفتره، اكتشفت صلته بالقيادة والحكم والضبط وبالسير والرحلة.
إن اليوميات، إذن، لا يمكن أن تنجو من الأرقام والحسابات، لذلك يستعيض أحياناً بعض كتّاب اليوميات عن الكتابة والسرد بوضع إحصائيات أو أرقام لا غير.
والأرقام لها دائماً دور كبير في الدفع باليوميات نحو التقدم، في بعدها الواقعي والتسجيلي، فذكر عدد الجنود القتلى أو الأسرى في يوميات عسكري في ساحة المعركة أو مراسل حربي حدث مهم مختصراً بأرقام، كما تسجيل مبلغ مالي في يوميات شخص مفلس بلا عمل وشريد.
في افتتاحية يومياتها “هروب، يوميات طفل شارع”، تؤكد الكاتبة الكندية إيفيلين لو، على مبلغ العشر دولارات التي تحملها معها في رحلة هروبها من المنزل العائلي، في أول يومية لها من يومياتها “هروب، يوميات طفل شارع”، لأن المال سيكون سبب شقائها بعد ذلك، والحاجة إليه للاستمرار في العيش ستدفعها إلى بيع جسدها على الأرصفة، فتسجل يوم “22 آذار/مارس 1986”:
“الوقت صباحاً، وأنا في مكتب إحدى الصحف الشبابية. هربت من المنزل أمس واتصلت بالأشخاص في صحيفة مكتبة المدرسة لأتوسل إليهم كي يستقبلوني لبعض الوقت. أفرغت خزانتي من دفاتري، اليوميات التي كنت قد خبأتها هناك، وسحبتها أسفل الممر وألقيتها في سلة المهملات، استمعت إليها وهي تسقط إلى أسفل. المؤكد أنها لم تكن لترافقني، لأن حقيبتي المدرسية كانت مليئة بالقصائد والقصص، وكتاب عن أسواق الكتّاب، وغيار ملابس، وعشرة دولارات”.
تبدو عبارة “عشرة دولارات” أكثر العبارات وقعاً بعد كلمة “هربت”، فالهروب من البيت الآمن والخروج من مسؤولية العائلية يصحبه ضآلة المبلغ، يجعلنا نتوقع كم المصاعب التي ستواجهها الطفلة الهاربة في شوارع “بريتش كولومبيا” الباردة.
في مثال آخر، يحصي الكاتب الإنجليزي جورج أورويل، بتاريخ 1 حزيران/يونيو 1940، الإشهارات زمن الحرب، أنواعها في الجريدة ونسبها من الأعمدة بدقة: الأكل، أدوات صحية، الدخان، الملابس، الرهان… لتعطينا فكرة عن أوضاع الاقتصاد والاعلام بلندن زمن الحرب.
بينما كتب أرنستو تشي غيفارا في يوميات بوليفيا يحصي غنائمه يوم 23 آذار/مارس: “الغنائم النهائية هي التالية: 16 بندقية موزر، 3 مدافع مورتو مع 64 قذيفة ب ز ، 3000 رصاصة موزر، 3 ي، س، ا، س، مع مخزونين لكل واحد، رشاش عيار 30 مع حزامين من الرصاص، هناك 7 قتلى و14 أسيراً، من بينهم 4 جرحى…”.
وأذكر أنه في يومياتي بالجزائر سنتي 2009 و2010، اكتفيت في يومية 25 تموز/يوليو، بنسخ نتائج الانتخابات الرئاسية المزورة في تونس، والتي فاز فيها زين العابدين بن علي بنسبة 89،62%، وكان توزيع النتائج على بقية المترشحين كافياً ليعكس طبيعة نظام الحكم في تونس، وحال الديمقراطية وعدم شفافية الانتخابات، ولم تكن تلك الأرقام تحتاج إلى مزيد من التفسير والتحليل.
إن اليوميات في كثير منها إحصاء للخسائر، لأن دورها “تقديم محصلة”، ويمكن أن تكون الحسابات غير مالية، كما تقول بياتريس ديدياي، متعلقة بالخلقة والأخلاق، وهي تعطي مثالاً من يوميات أميال: “كم ألحقت بي الأشهر القليلة الماضية من بشاعة وشيخوخة! كم هو انهيار سريع ومتواصل! غزو الشيب، استطالة الأسنان، بداية تجاعيد، بياض اللحية، فقدان البشرة لنضارتها، اكتمل كل شيء”، ويمكن أن نعثر على هذا الجرد للخسائر في العديد من اليوميات، منها يوميات حسونة المصباحي “يوميات الكورونا”، وهو يسجل رعبه من الشيخوخة بعد أن اكتشف أن سنّه يتحرك.
وتكتب سيلفيا بلاث يوم الأربعاء 7 كانون الثاني 1959، متحدثة عن عدم تمكنها من التحكم في وقتها، ولا في تنفيذ وعودها بخصوص الكتابة، وترجع ذلك إلى انحدارها نحو الشيخوخة قبل الأوان: “لا أستيقظ في الصباح لأني أريد العودة إلى الرحم. من الآن فصاعداً… احرصي على أن تبدئي الكتابة قبل 9، فذلك ينزع اللعنة. إنها الآن تقريبا 11. غسلت كنزتين، مسحت أرضية الحمام، غسلت صحون اليوم، رتبت الفراش، طويت الملابس المغسولة وحدقت في المرآة إلى وجهي برعب: وجه شاخ قبل أوانه، أنف قصير بدين يشبه سجقاً راشحاً، مسام كبيرة ملأى بقبح وقذارة، بقع حمر، الشامة البنية أسفل ذقني والتي أود أن تستأصل. ذكرى عن وجه الفتاة ذاك الذي شاهدته في فيلم في كلية الطب، بثؤلول جمال أسود صغير. هذا الثؤلول خبيث: ستموت هي في غضون أسبوع… شعر غير مرتب، مجرد بني صبياني مرفوع. لا أعرف شيئاً آخر أفعله به. مرتخية. جسد بحاجة إلى شغل. بشرة أسوأ بسبب المناخ: بارد يشقق الجلد، حار يجففه. أنا بحاجة إلى أن أكون سمراء من رأسي حتى قدمي، وتصح بشرتي فأكون على ما يرام…”.
هكذا تلعب الأرقام والحسابات دورا مهما في نقل حال كاتب اليوميات المادية والنفسية وتؤصّل التدوين في فن اليوميات، القائم أساساً على التكثيف من ناحية، وعلى التشظي وعدم الحاجة للسرد طوال الوقت من ناحية ثانية، لينصب الكاتب قيامة كل ليلة لنفسه وما ارتكبت.
—————
اليوميات أو دفاتر الحساب والموت II
يقول الناقد الفرنسي جورج ماي في كتابه السيرة الذاتية: “ما أكثر[السير الذاتية] التي تبدو كأنها محاولات يائسة للانتصار على الزمان والموت” أما ظاهرة تسجيل اليوميات، بوجهيها الكلاسيكي والمعاصر فلا يمكن النظر فيها إلا من حيث هي مقاومة للموت ورعب من فناء العمر إن كان الذي يتهددها خطرا بشريا أو قدر التقدم في العمر أو سقم، فكاتب اليوميات يسجل تآكل عمره يوما بيوم ومن هذه الزاوية فهو في قلب الحساب والمعادلات. أما متن اليوميات والذي يميل فيه البعض إلى اعترافات ضمنية بالخطايا اليومية فهو بدوره تفكير ما بيوم الحساب لكن بإقامة قيامة يومية للنفس.
اليوميات والموت والانتحار
ربما الخوف من النفاد والنهاية والتقدم في العمر والموت هي التي دفعت بآن فرانك أن تكتب يوم 10 أكتوبر 1942 بجانب صورتها “هذه هي صورتي، وأريد أن أبقى في هذا الشكل” وهي الفكرة ذاتها التي ظلت تدفع ببعض كتاب اليوميات إلى وضع حد لحيواتهم، على النحو الذي دفع بالشاعرة الأمريكية سلفيا بلاث أو الشاعر والروائي الإيطالي تشيزاري بافيزي صاحب كتاب مهنة العيش إلى الانتحار.
ظلت سلفيا بلاث تسجل آلامها في يومياتها وتشبه حياتها بالموت فتكتب يوم السبت 2 أوت: “عندي شعور طاغ بالمرض، أنا مريضة بكل معنى الكلمة. حياة دون القيام بشيء هو موت. حياتنا هي على نحو سخيف مرتدة للداخل، حياة جلوسية”.
أما حالة بافيزي فتبدو أكثر دلالة في علاقة اليوميات بالموت فقد انتحر الكاتب بعد أيام قليلة من قراره التوقف عن كتابة يومياته. فبدت ممارسة اليوميات معه تأجيلا لموت قديم شعر به يطرق بابه مع أول تدوينة سجل فيها احتضاره الأدبي. فالفترة التي تغطيها اليوميات ما بين تاريخين اثنين؛ 6 أكتوبر عام 1935 و18 أوت 1950 كانت فترة مقاومة الموت وعبر اليوميات ذاتها. حاول بافيزي الهروب من الانتحار منذ بداية تسجيله ليومياته وكان يعترف كل مرة أنه يقاومه حتى انهزم أمامه سنة 1950.
وكثيرا ما توقف بافيزي يتأمل في ظاهرة الانتحار ومحللا إياها ومنظّرا، تلك الظاهرة التي رأى أنها نتيجة صفة أصيلة في الإنسان، أي انسان فسجل يوم 23 مارس 1938: “لا أحد يفتقر إلى سبب معقول للانتحار” غير أن المقدم على الانتحار، بالنسبة إليه، عليه أن يتمتع بكفاءات تمكنه من الانتحار بنجاح فيكتب يوم 24 أفريل:
“[…] يبدو الانتحار أشبه بواحدة من تلك الأفعال الأسطورية للبطولة، تلك التوكيدات، في الخرافات، عن كرامة “انسان” في وجه “القدر”، والتي تنتج أوضاعا مثيرة للاهتمام لكنها لا تمت إلينا بصلة. المدمر لذاته نوع مختلف، أكثر يأسا إنما عملي أكثر، مضطر لاكتشاف كل عيب، كل جبن في طبيعته ذاتها؛ ثم يشاهد هذه الميول على نحو لين بحيث تصبح مدرد لا شيء، هو يبحث عن الأكثر، يستمتع به، يجده مسكرا. هو واثق من نفسه أكثر من أي فاتح في الماضي، وهو يعرف أن الخيط الذي يربطه بالغد، باحتمالات الحياة، بمستقبل رائع، هو سلك أقوى، عندما يكون محكم الشدّ، من أي إيمان أو نزاهة. والمدمّر لذاته هو، قبل كل شيء، شخص فكه جدا وسيد نفسه. لا يفوّت أبدا فرصة الإصغاء إلى نفسه وإثباته نفسه. هو متفائل، يتمنى كل شيء من الحياة. المدمر لذاته لا يطيق العزلة. لكنه يعيش في خطر دائم من أنه ذات يوم سيتفاجأ بنوبة من إبداع شيء ما أو وضع كل شيء في نظام ملائم، حينذاك سيعاني على نحو لا ينقطع وحتى يمكن أن يقتل نفسه”.
ظل بافيزي يعود كل مرة إلى الحديث عن الموت والانتحار حتى فعلها وعن وعي تام عندما ختم يومياته بتاريخ 18 أوت 1950 كتب: “الشيء الذي يخافه المرء في السر، يحدث دائما.
أكتب: آه يا أنت، ارحمنا، وماذا بعد؟
قليل من الشجاعة يكفي.
كلما أصبح الألم بيّنا ومحدّدا، كلما فرضت غريزة البقاء نفسها، وتقلّص التفكير في الانتحار.
يبدو سهلا حين التفكير فيه. امرأة ضعيفة أقدمت عليه. إنه يتطلّب ضعة لا كبرياء.
كل هذا مقيت.
لا كلمات. حركة. لن أكتب بعد الآن”.
كتب ذلك بعد أن يئس من السياسة ومن جسده الخاص ومن النساء ومن الكتابة.
إن هذا القرار والاحجام عن الكتابة هو نفسه اعلان انتحار ما قبلي جسّده فعليا بعد تسعة أيام مما يؤكد الرأي بأن وجود كاتب اليوميات يصبح رهين استمرار اليوميات نفسها وتوقفها يحيل وجوده إلى شاهدة على قبر ما تحتلها التواريخ والأرقام تحت اسمه مشيرة إلى تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته وكأن الحياة كلها عند كتاب اليوميات تردد عبارة تشارلز بوكوفسكي “لا تحاول” التي كتبت على شاهدة قبره بعد ذلك. بوكوفسكي كان بدوره واحدا من الكتاب الذين اهتموا باليوميات مخضعها لمزاجه الخاص ورؤيته الخاصة للأدب فكتب “يوميات عجوز قذر” و”ملاحظات يومية لرجل عجوز”.
اليوميات العربية والموت
يؤكد الفكرة، في المدونة العربية، الروائي الفلسطيني غسان كنفاني الذي هرع إلى فن اليوميات نتيجة ذلك الإحساس بأن الموت بكل ألوانه يحاصره؛ الاغتيال السياسي ومرض السكري، لذلك كان يلاحق ذلك العمر القصير عبر كتابة اليوميات والكتابة القصصية والروائية وربما هذا ما يفسر بقاء أعماله غير مكتملة. كانت الرغبة في أن يكتب أكثر ما يمكن أكبر من الرغبة في انهاء عمل بعينه. ألا يذكرنا هذا بكافكا ومخطوطاته غير المكتملة؟ كان أيضا، تحت فوبيا الموت القادم. ولأن كاتب اليوميات عموما كائن استشرافي لأنه ملتحم بحاضره وماضيه ولأنه ينطلق في الكتابة في غالب الأحيان من إحساسه بالخطر الذي يتهدد حياته.
يكتب كنفاني يوم” 1/1/1960
.. ليلة أمس قررت أن أبدأ من جديد..
هذه اليوميات عمل كريه، ولكنه ضروري كالحياة نفسها..
أتى القرار بسرعة وببساطة، كانت الساعة تمام الثانية عشرة، أي أننا كنا ننتقل من عام قديم إلى عام جديد.. كانت الغرفة صامتة، تعبق برائحة وحدة لا حد لها.. عميقة حتى العظم، موحشة كأنها العدم ذاته.. وبدا كل شيء تافهًا لا قيمة له، فقررت أن أكتب شيئًا.. لكنني فضلت، لحظتذاك، أن أبكي.. ومن الغريب أنني فعلت ذلك ببساطة، ودون حرج، وحين مسحت دمعة، أو دمعتين، كنت كمن يهيل التراب على جزء آخر من جسد ميت سلفًا ندعوه حياتنا..
وهأنذا أكتب من جديد… يوميات كريهة، لحياة كريهة تنتهي بموت كريه، مستشعرًا كم أنا مجبر على أن أكتب، كم أنا مجبر على أن أعيش، كم أنا مجبر على أن أموت..”
إن كلمة “هرع”، التي اخترناها أعلاه عمدا، يؤكدها غسان كنفاني عندما يتحدث في اليومية نفسها عن الإجبار فالكتابة ليست اختيارا بل شيء كريه يجب أن يقوم به ليستمر في العيش أو يؤجل الموت. وهو الشيء الذي تدعمه اليومية الثالثة بتاريخ 4/1/1960 التي يتحدث فيها غسان كنفاني عن مرضه بداء السكري:” إنني مريض، نصف حي يكافح من أجل أن يتمتع بهذا النصف، كما يتمتع كل إنسان بحياته كاملة.. وكل المحاولات التي افتعلتها لكي أنسى هذه البديهية تقودني من جديد لكي أواجهها.. وبصورة أمر.”
ثم يفصل كنفاني هذا الاعتراف في آخر اليومية عندما يعتبر أن الألم هو الثمن الذي يقدمه من أجل أن يستمر في العيش فيقول:” دفعني لأكتب هذا الكلام.. جرح سببته الحقنة اليومية هذا الصباح.. وأعتقد أنه مازال ينزف إلى الآن.. لو قلت لإنسان ما إنني أتألم منه لأعتبره شيئًا يشبه النكتة الطريفة.. ويرددها على هذا الأساس، متسائلًا: “كيف يستطيع إنسان أن يجرح نفسه؟ لا شك أنها تجربة طريفة!!” أو أنه على أحسن الاحتمالات سوف يقول: “إنه يتألم!” ويغير الموضوع.. أما بالنسبة لي فهي تعني، وسوف تبقى تعني كل يوم، أنني أريق جزءًا من احتمالي، وإنسانيتي، وسعادتي من أجل أن أعيش… وإنه لثمن باهظ حتمًا.. أن يشتري الإنسان حياته اليومية بالألم.. والقرف.. والنكتة.. إنه ثمن باهظ بلا شك.. أن يشتري حياته اليومية بموت يومي”.
وذات الأمر يمكن رصده في يوميات الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي فقد شكل تشاؤمه من حال التونسيين وخمولهم ومرض وقسوته وفشله العاطفي أسُسَ حضور الموت في يومياته الذي كان امتدادا لحضوره في شعره ونثره الإبداعي. ولعل فاجعة موت حبيبته وموت أبيه وانتظاره لموته الخاص كانت أهم مظاهر ذلك الحضور.
وإن بدايته تسجيل يومياته بمناجاة الموتى يجعل من الموت نفسه دافعا لهذا الاحتفاظ باليوميات فأول يومية بتاريخ 1 جانفي 1930 يفتتحها بقوله :
في سكون الليل، ها أنا جالس وحدي، في هاته الغرفة الصامتة إلى مكتبي الحزين، أفكر بأيامي الماضية التي كفّنتها الدموع والأحزان… وأستعرض رسوم الحياة الخالية التي تناثرت من شريط ليلي وأيامي ، و\هبت بها صروف الوجود إلى أودية النسيان البعيدة النائية.
أنا جالس وحدي في سكون الليل، أستعرض رسوم الحياة، وأفتكر بأيّامي الجميلة الضائعة، وأستثير أرواح الموتى من رموس الدهور”.
ويكتب يوم 13 جانفي 1930 متحدّثا عن استحضار موت والده واحتضاره بالتفصيل:
“… أراه وقد اشتدت عليه وطأة الداء، وأصبح يعالج ألم الموت ونزاع الحياة، والطبيب يحقنه بأدوية كثيرة. ثم يخرج يائسا مخفيا يأسه عنّي أنا المسكين الصغير…
وأراه وقد شمله الموت براحته، فأصبح ساكن الطائر، متّزن النفس، تخاله في حلم النائم المطمئن، والنساء يبكين في قلب الليل ويملأن فجاج الأفق برنّات النياحة، وأنا كالطائر الذبيح أكاد أجنّ من الحزن والنحيب، طورا أقف عند رأسه، وأخرى عند رجليه، وأخرى أجلس على يمينه، وأخرى عن شماله، وبيميني هاته أجرّعه من حين لآخر جُرعا من الماء يكاد يمازجها دمعي المنهلّ، وتكاد تريقها هزّات تسبيحي. ثم رأيته التفت إليّ وأوقف مقلتيه، فحسبته يرنو إليّ فاقتربت منه قائلا: أبي! أبي! ماذا تريد؟ لكن آه يا قلبي لقد كانت تلك نظرة الموت، حسبتها نظرة الحياة تدعوني. ثم لوى عنقه وشخص ببصره وارتجفت شفتاه بالشهادة لم لم يفتر عن تردادها، ولفظ النفس الأخير.
لقد مات أبي أيها القلب. فماذا لم بعد في هذا العالم. مات أبي وظللت أنتحب وأنوح وأبكي بكاء النساء، ثم طبعت على جبينه البارد قبلة كانت آخر عهدي به. فسلام عليه يوم ولد، ويوم مات، ويوم يبعث حيا، رحم الله روحه الطاهرة الكريمة…”.
كان الشابي منذورا للموت ومنتظرا له في كل حين ومحاصرا به ببعديه الحرفي والرمزي حتى في نقله للحياة الأدبية والثقافية في عصره حيث تنهار المؤسسات وتموت وهي أجنّة حتى وصل إلى قولته الشهيرة “لقد أصبحت يائسا من المشاريع التونسية، ناقما على التونسيين، لأنني أراهم يقولون كثيرا ولا يعملون إلا قليلا”.
مسرحة الانتحار عند كتاب اليوميات
إن النظر في انتحار بعض كتاب اليوميات يكشف ذلك الاحتفاء بالموت والحرص على إتقناه، فكان المقدمون عليه، يحكمون مسرحته في مشهدية مثيرة ويعملون على نجاحه التام خاصة إذا تكرر فشلهم. هكذا فعلت سيلفيا بلاث عندما حشرت رأسها في الفرن وأحكمت غلق الفجوات تحت الباب بالمناشف حتى لا يتسرب الغاز خارج المطبخ ويصل أطفالها في الغرفة الأخرى. وكذلك حرصت فرجينيا وولف على اثقال جيوبها بالحجارة لكي لا تطفو وتغرق بنجاح ولعل قصة الكاتب المصري وجيه غالي مع الانتحار تمثل نموذجا واضحا على مسرحة الانتحار والتحكم في الفضاء الفرجوي عندما خطط لذلك وهو يكتب آخر يومياته ويوصي عشيقته الكاتبة الإنجليزية ديانا آتهيل بتحريرها ونشرها وتسديد ديونه ثم اقدامه على التهام علبة كاملة من الأدوية ووضع ورقة على الباب يحذر فيها صديقته من دخول البيت، الذي هو بيتها، ويطلب منها استدعاء الشرطة” ديانا لا تدخلي، اتصلي بالشرطة فورا” ليترك بجانبه ورقة يقول فيها ” أظن أن الانتحار هو الشيء الوحيد الأصيل الذي فعلته في حياتي”. أما التونسي محمد العريبي والذي كتب مذكراته ومازالت ضائعة إلى اليوم، وجرب كتابة القصص على شكل اليوميات مؤكدا وعيه وتعلقه بهذا النوع من الكتابة فقد مسرح انتحاره بطريقة خاصة جدا عندما ربطه بحفلة عيد الميلاد حين خرج مع عشيقته فالنتين للاحتفال وبعد سهرة طويلة عابثة عاد إلى بيته بباريس وانتحر بغاز الاصطباح في 25 ديسمبر 1946.
ولعل مسرحة الانتحار واعطائه صبغة قصصية تضفي عليه دهشة أمر اشترك فيه كتاب “الكتابة عن الذات” كلهم من همنجوي إلى ميشيما وستيفين زفايغ وغيرهم مؤكدين بذلك أن مواجهة الذات أصعب من مواجهة أي عدو وترصد الذات أفظع من المشاركة في الحروب.
إن هذا الانهمام بموضوعة الموت يمكن أن نلمسه في جل التجارب المنجزة في أدب الذات عموما وفن اليوميات خصوصا، شرقية كانت أم غربية وفي كل الأزمنة، فهي ثابتة في يوميات سرير الموت للمغربي محمد خير الدين التي خصصها لمعاناته من مرض السرطان طيلة شهر أوت 1955 بالمستشفى العسكري بالرباط وهي قائمة في في قبضة الكابوس اليوميات التي نقل عبرها السوري جان دوست تجربته مع فيروس كورونا والحجر الصحي بألمانيا سنة 2020 وهي مؤكده في يوميات الحداد1977- 1979 التي التي خصصها رولان بارت لأثر موت أمه عليه وهي أحد المواضيع المركزية في يوميات برلين1940-1945 للأميرة الروسية مارى ڤاسيلتكيكوڤ التي سجلت فيها آثار قصف برلين ومحاولة اغتيال أدولف هتلر وكان الموت بطلا في امرأة في برلين للصحفية الألمانية مارتا هيلرس والتي نقلت فيها ثمانية أسابيع تحت الاحتلال الروسي سنة 1945 وبلا شك كان الموت معلنا في يوميات فتاة شابة لآن فرانك التي نقلت فيها رعب الاضطهاد النازي لليهود أثناء احتلال هتلر لهولندا 1942 أين كانت مختبئة هي وعائلتها قبل أن يتم القبض عليهم.
ومن ثم فلا يمكن لليوميات، عادة، أن تنجو من فكرة الموت وتدبّره لأنها نشأت في الفاجعة وترعرعت في هذا الإحساس الجنائزي؛ “حميمية” كانت هذه اليوميات مغرقة في ذاتيتها أو “خاصة” منفتحة على العالم والآخر. فزحمة الأرقام والتواريخ والحسابات في مواجهة الذات في عرائها التام واليومي تعجّل بدخول تلك الذات في سوداوية قد تفتك بها. يقول رولان بارت في يوميات الحداد بتاريخ 30 أكتوبر “إن كون هذا الموت لم يدمرني تماما، يعني بالتأكيد أني أريد الحياة بشدة، إلى درجة الجنون، ومن ثم فإن الخوف من موتي أنا شخصيا مازال موجودا، ولم يتزحزح قيد أنملة”.
———————————–
اليوميات والفشل العاطفي III
لئن كانت اليوميات، من جهة، هي الفن الأكثر حميمية وملامسة لدواخل الذات، وإذا كانت العواطف، من جهة أخرى، هي الأمور الأكثر تعقيداً في تركيبة الكائن البشري بتحولاتها وتغيراتها، وهي الأكثر هيمنة على سلوكه وتفكيره، ما يجعل الكائن البشري كائناً عاطفياً بالدرجة الأولى، فإن هذا ما يرشح اليوميات لتكون الفن الأكثر تعبيراً عن هذا الكائن العاطفي.
فلا يمكن أن نغفل عن أن اليوميات ترعرعت تحت وسائد الفتيات في اليابان وأوروبا مضمخة بدموعهن، لتظل ظاهرة الاحتفاظ باليوميات مرتبطة بعالم المراهقين إلى اليوم بالتوازي مع ممارستها كنشاط فني، وظلت علاقتها بالبوح العاطفي قائمة حتى مع كبار المؤلفين والفنانين، وهذا ما تؤكده مدونة اليوميات العالمية، وخاصة منها اليوميات الكلاسيكية والمتعلقة بالحياة الخاصة للكاتب والمعروفة بـ”اليوميات الحميمة”، تلك التي تكشف لنا الهشاشة العاطفية لكتّاب اليوميات، فعدد من مشاهيرهم يعاني من الإخفاق العاطفي: فرانز كافكا وفرناندو بيسوا وتشيزاري بافيزي وغسان كنفاني وهانس كريستيان أندرسون وفرجينيا وولف وأنييس نن واندريه جيد والشابي…
العزلة والحب
ليس هناك من كتابة تتطلب العزلة والسرية كما اليوميات، فهي الممارسة الأكثر سرية في حيوات الكتّاب، حيث ينسحب الواحد منهم نحو محرابه الخاص لممارسة هذا الفعل؛ تسجيل اليوميات، كما ينسحب الكائن البشري من الفضاء العمومي إلى الفضاء الحميم والسري لممارسة الحب. فالحب بمفهوميه؛ الجنس والعواطف، لا يمكن أن يتدفق إلا في السر وفضاء العزلة، باعتباره ينتمي إلى عالم الحميم؛ “الانتيم”. وهما، ونعني ممارسة الجنس وإعلان العاطفة، يُشوّشَان ويُشوّهان في الفضاء المشترك والمعلن.
وبالرجوع إلى أصل كلمة intime الفرنسية وأصلها اللاتيني intimus، تتكشف لنا صلة ما يعرف بـ”الأدب الحميم” بالعالم الداخلي للذات، مقارنة ببقية أنواع الأدب الأخرى التي يمكن أن ندرجها في عالم الاكستيم extime؛ العالم الخارجي والمشترك والجمعي. وهو ما يتقاطع مع المعنى المعجمي العربي وتؤكده الإحالة على معنى القرب في قوله تعالى في سورة الشعراء: “فما لنا من شافعين ولا صديق حميم”، وإحالة على الساخن في وصف ماء الشرب في جهنّم كعقاب أخروي، يقول تعالى: “والذين كفروا لهم شراب من حميم”، وبإرجاع هذه المعاني كلّها إلى اليوميات باعتبارها اعترافات يومية على النفس للنفس ومكابدة التعرّي والحرص على إخفاء ذلك عبر وجوب بقاء التجربة في السرّ نصل إلى معنى العذاب الذاتي.
وكل هذا يدفع بممارسة اليوميات لتكون فعلاً شبقياً ذاتياً يطلب صاحبه اللذة متحملاً الألم وحده، دون نية في امتلاك شريك غير دفتر اليوميات نفسه.
هانس فرخ البط القبيح
قليلون الذين يعلمون بحزن ملك الخرافة وأدب الأطفال، الكاتب الدنماركي الكبير هانس كريستيان أندرسون، صاحب القصص الشهيرة؛ “ملكة الثلج”، “عقلة الإصبع”، “بائعة أعواد الثقاب الصغيرة” و”فرخ البط القبيح”. كان رجلاً خجولاً وعاشقاً أبدياً لم يسعفه الحب أبداً، وظل معلقاً بمشاعر من جهة واحدة.
تذكر الحكايات حول سيرته أنه وُجد ميتا في الرابع من آب/أغسطس عام 1875وعلى صدره صندوق به رسالة طويلة من ريبورغ فويغت، حبيبته التي رفضته أيام الشباب. عاش هانس حياته كاملة يتلقى الرفض من كل الفتيات اللاتي تجرأ على التصريح لهن بحبه. ولم تكن مغنية الأوبرا السويدية جيني ليند استثناء، ولم تنفع قصته “العندليب” التي كتبها من وحي حبه لها والتي منحتها لقب “العندليب السويدي”، في جعله يتمتع بذلك الحب، بل كانت تذكّره كل مرة أنه ليس أكثر من أخ وأن مشاعرها نحوه لا ترتقي إلى مشاعر امرأة نحو رجل.
كانت يومياته التي ظل يكتبها طيلة خمسين سنة، من 1825 إلى سنة 1875، مسرحاً لإفراغ تلك الخيبات وذلك الحزن الذي احتله طوال حياته، وانعكس على قصصه وخرافاته، حتى أنه عندما يسأل عن نفسه أو عن الصعوبات التي واجهته ليحقق ذلك النجاح يرد: اقرؤوا “فرخ البط القبيح”.
إن هذه الإشارة لهذه القصة بالذات تعكس في جانب منها وعياً من الكاتب بأنه كان منبوذاً لشكله، وأن نجاحه الأدبي لم يحقق له السعادة، فلا أحد يعلم بمشاعر فرخ البط القبيح في نهاية القصة سواه.
يكتب كريستيان أندرسون بيومياته يوم 20 أيلول 1825: “ما الذي يمكن أن أكونه؟ ما الذي سأصير عليه؟ مخيلتي الحية تأخذني الآن إلى بيت المجانين ومشاعري العنيفة تدفعني إلى الانتحار. سابقاً، كان يمكن لهذا التعالق أن يجعل مني شاعراً عظيماً. يا إلهي…”.
كنفاني العاشق المتيم
عاش الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني قصة حب كبيرة مع الكاتبة السورية غادة السمان، تعرّف القراء على بعض تفاصيلها في كتاب “الرسائل” الذي نشرته غادة السماء إثر اغتيال غسان كنفاني، غير أن يوميات غسان كنفاني التي نشرت منذ سنوات قليلة تكشف جانباً آخر من الحكاية العاطفية التي جمعت بين الكاتبين، وبدا فيها غسان كنفاني معترفاً بحبه لغادة، ولكنه يتهرّب منه محاولاً التخفيف عنها في اليوميات، ويطلب منها أن تصّعد العلاقة إلى علاقة صداقة، ويربط هذا الطلب وهذا التخلي بقدر الموت الذي يحاصره نتيجة مرضه، ولا يريد لحبيبته أن ترتبط برجل ميت حتماً.
يقول واصفا العلاقة التي تربطه بغادة السمان يوم 21 شباط/فبراير 1960:
“كتبت اليوم رسالة إلى (…) ( و(…) كانت قصة حب بلا شك، أما الآن فهي مأساة… إن رسائلها الأخيرة لي كانت تحمل طابعاً خاصاً. كأنها كانت تريد أن أقول موقفي بوضوح كي تعرف ماذا يتعين عليها أن تفعل. وهذا من حقها بلا أدنى شك. لقد كتبت لها رسالة اليوم حاولت أن أكون فيها مخلصاً لها ولنفسي”.
ويضمّن غسان بطريقته الفنية رسالته في اليومية، وفيها ينطلق الكاتب من تشخيص حالته الصحية التي تتدهور يوماً إثر يوم: “أنا مشوش جداً… لذلك تبدو أفكاري مهزوزة. والذي يشوشني خبر زفّه الطبيب إليّ ظهر أمس. لقد بدأ هذا القلب المسكين يتعب… إنه يخفق بلا جدوى… وحينما أنظر الآن إلى الأشياء أحسّ بأنني خارجها… إنها مسحوبة من المعقول… إنني لا أخاف الموت، ولكني لا أريد أن أموت …لقد عشت سنوات قليلة قاسية، وتبدو لي فكرة أن لا أعوض فكرة رهيبة… إنني لم أعش قط… لذلك فأنا لم أوجد… ولا أريد أن أغادر دون أن أكون، قبل المغادرة موجوداً… أتعرفين الذي أعنيه؟ إن شعوري غريب جداً… شعور إنسان كان ذاهباً إلى مكان ما كي يتسلم عملاً ملائماً، فمات فجأة في الطريق… إن شعوري الآن هو هذه (الفجأة) بالذات…”.
كانت هذه اليومية من أطول يوميات غسان كنفاني وبدت مكتوبة بعقلانية ومنهجية على غير عادة اليوميات التي تأتي متشظية ومشوّشة، فبعد طرح الموضوع ونسخ الرسالة التي كشفت عن مرضه الذي يدفعه إلى التخلي عن علاقته بغادة، يعود غسان ليحلل ويؤكد على أن هذا التخلي يأتي من عدم رغبته في توريط أحد معه، حتى لا يشعر بالذنب وأنه تسبب في تعاسته.
بعد أقل من سنة يتزوج غسان كنفاني من آني هوفر؛ مدرسة دنماركية التقاها في يوغسلافيا في مؤتمر طلابي، زارت بعد ذلك لبنان ورافقها غسان في زيارة إلى المخيمات للتعريف بالقضية الفلسطينية، وطلب يدها بعد أقل من عشرة أيام من تعارفهما، ليتزوجا يوم 12 ديسمبر 1961 ويرى أنه عرض عليها الزواج قائلاً:
“هل تتزوجيني؟ أنا فقير لا مال لي ولا هوية. أعمل فى السياسة ولا أمان لي. وأنا مصاب بالسكري”.
ولكن لماذا لم يخف غسان كنفاني من الارتباط بآني الدنماركية؟ أين كان ذلك الإحساس باليأس والشعور بالموت القريب؟ هل كان حباً من أول نظرة أم هو هروب من حب مميت آخر، احترفت فيه غادة السمان فن الغواية الشرقية القاتل، عبر الشد والجذب، حتى قرر غسان أن ينسحب من اللعبة؟ ليس هناك من إجابة إلى الآن عن حقيقة قرار غسان كنفاني بوضع حد للعلاقة، والتي حاولت غادة السماء بعد ذلك بنشرها لرسائل غسان أن تؤكد أنها كانت معشوقة غسان الأبدية. كانت الرسائل فعلاً تظهر ولعه بها وهيامه الروحي والجسدي، وكان لا يخفي عشقه ولا اشتهاءه لها رغم زواجه.
إن فن الترسل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفن اليوميات، لذلك يتقاطعان ويتداخلان، فكلاهما كتابة حميمية، الأولى للآخر الحميم والثانية للذات الحميمة، لذلك لا يمكن قراءة قصة الحب التي جمعت بين غسان كنفاني وغادة السمان من اليوميات دون استحضار الرسائل التي نشرتها غادة السمان. كشفت تلك الرسائل أن علاقة الحب ظلت مستمرة من ناحية غسان كنفاني، وظل يراسلها ملتاعاً حتى بعد أن كتب لها رسالة التخلي التي أوردها في اليوميات، وبعد سنوات من زواجه بالدنماركية وانجابه لابنيه وآخر رسائله كانت بتاريخ 25 آب 1968. ومع ذلك تبقى تلك العلاقة لغزاً، فلم تضمّن غادة رسائلها في الكتاب المنشور ولا نشرت عائلة غسان رسائلها.
إن ما تكشفه الرسائل، وهي امتداد لليوميات، هو واقع الإخفاق العاطفي لغسان كنفاني وتواصله بعد الزواج والإنجاب، ولا نعلم إذا كانت تلك المقاطع من يومياته التي دفعت بها زوجته الدنماركية إلى مجلة الكرمل لنشرها، والتي جُمّعت بعد ذلك في كتاب مع يومياته الصحفية، هي كل اليوميات التي كتبها كنفاني، أم أن العائلة أعدمت أو أخفت بقية اليوميات لأسباب قد تكون متعلقة باستمرار هذه العلاقة بين غسان كنفاني وغادة السمان.
فالزوجة لم تسمح إلا بيومية واحدة كانت إعلان تخلي غسان عن غادة، تلك اليومية التي نسخ فيها رسالته التاريخية. ويبدو من سياق الأحداث وردّات الفعل أن إقدام غادة السمان على نشر رسائل غسان كنفاني التي وجهها لها، ورغم المقدمات الطويلة التي حبّرتها، كانت ردة فعل على نشر اليوميات وتلك اليومية بالذات، خاصة أن قرار النشر يأتي من “غريمتها العاطفية” زوجة حبيبها الشهيد. وكأن هناك تنازعاً بين اليوميات والرسائل وبين الحب ومؤسسة الزواج.
إن المتأمل في الرسائل سيلاحظ أن غادة السمان لم تنشر رسائل غسان كنفاني الأولى والسابقة لزواجه، فهل في ذلك إشارة واضحة لدوافع النشر؟ ومن تأمل أطوار هذه الحكاية العاطفية بين غسان وغادة ينبت سؤال آخر: هل كانت غادة السمان فعلا حبيبة مشتهاة أم هي مجرد دفتر أيضا يلوذ به ليخزن فيه غسان كنفاني أوجاعه وأفكاره، كما كان يفعل مع اليوميات، وكما لمّح لذلك كافكا في علاقته بميلينا؟
كافكا الخاطب الأبدي ومحطم سرير الزواج
“كافكا الخاطب الأبدي” هو عنوان رواية للفرنسية جاكلين راؤول دوفال، وهو عنوان يلخص الحالة العاطفية لكافكا، فالخطوبة عادة هي العتبة الأولى التي تمهد لدخول الفرد إلى مؤسسة الزواج، وهي طريق الحب نحو الوصال الكامل، غير أن بقاء الفرد في مرحلة العتبة الخارجية يعني أن تلك الذات وقع تثبيتها في مرحلة الوجود بالقوة بلغة الوجوديين، أو مرحلة ما قبل الإشباع أو لحظة الشوق.
كان كافكا لا ينجح في الوصول بالعلاقة إلى الزواج كل مرة، ودائماً ما كان ينتهي مسار العلاقة العاطفية عند الخطوبة.
لم ينجح كافكا لا مع ميلينا ولا فيليسي ولا غريتي ولا حتى النساء الأخريات، كن يدخلن حياته وبمجرد توغلهن فيها يأخذن طريق المغادرة.
يقول لويس غروس في كتابه “ما لا يدرك”: “التزم كافكا بالزواج في ثلاث مناسبات، مرتين مع الموظفة البرلينية فيليسي باور، ومرة مع السكرتيرة بنت براغ جولي ووهريزك. ولكن في اللحظة الأخيرة، وفي جميع الحالات، انسحب من المسرح مختاراً عذاب العزلة المغوي. صحيح أن كافكا، في أواخر أيامه، وبعد الحب المضطرب وشبه الأخوي الذي عاشه مع ميلينا جاسينسكا، عاش ستة أشهر مع ديورا ديامنت، وهي يهودية برلينية في التاسعة عشرة من العمر، كان ينوي الزواج بها، لكنَّ الأمر لم يتحقق، إذ إن موته المُبكر قد ربح الجولة”.
كل هذا الإخفاق يؤكده الكاتب الأرجنتيني لويس جروس في كتابه “ما لا يُدرك”، والذي خصصه للحياة العاطفية لكل من التشيكي فرانز كافكا والبرتغالي فرناندو بيسوا، والإيطالي تشيزاري بافيزي.
ويرى في الرسائل واليوميات فضاء للبوح بكل الحميم والمسكوت عنه، فيقول: “سواء في الرسائل أو في اليوميات الحميمة، يتعرى المخاطبون أمام الأشباح، وهذا صحيح إلى حد ما، فالتعري لا يكون كاملاً أبداً، ذلك أنه حتى النص الأكثر عرياً تتخلله حجب لا متناهية. ومع ذلك، ثمة شيء ما قد يرشح عبر الشرخ، تحدث المعجزة جزئياً بفضل العنصر الاستعرائي والسير ذاتي الذي تحويه الرسائل، اليوميات والأدب بوجه عام”، وهو ما اعتمده كافكا لتلبية حاجاته التي لم يشبعها في الواقع التواصلي المباشر. وكان كافكا أحياناً يشعر بالذعر من أن يُخْسره الحب علاقته مع نفسه وخاصة وحدته، ويرى فيه تنازلاً كبيراً عن حياته المنظمة وفق عمله ككاتب، وتنهض تلك الالتزامات التقليدية، من نحو العثور على بيت وتأمين أثاث، معرقلات وانحرافات كبرى بحياته التي ارتآها.
يقول الناقد لويس جروس: “لقد أيقظت فيليسي في كافكا رغبة حقيقية في الزواج وتكوين أسرة. لكنها، في الآن ذاته، أثارت ما يسميه الكاتب لاحقاً بـ(أكبر ذعر) في وجوده، كان كل شيء يبدو له مزعجاً: خلال بحثه عن شقة لهما، لم ير في الحجيرات سوى تقليد للقبور، وكان يحس بضيق في الصدر وهو يختار أثاث البيت ويذكر الخزانة على وجه خاص”، وسيقول لميلينا يوما إنه “لا يستطيع أن يذهب معها أبعد من الرسائل”.
يكتب كافكا في يومياته يوم13آب/أغسطس:
“ربما يكون كل شيء قد انتهى، وتكون رسالتي التي كتبتها يوم أمس هي الأخيرة، سيكون ذلك من الأفضل، وما سأعانيه ستعانيه، وهذا لا يقارن بالمعاناة المشتركة التي ستنتج، سأنسحب تدريجياً وهي ستتزوج، ذلك هو المخرج الوحيد للأحياء. نحن لا نستطيع أن نشق معاً طريقاً واحداً إلى الصخرة؛ فيكفي أننا بكينا وعذبنا أنفسنا مدة سنة…”.
ويعود في يومية أخرى بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر ليحسم الأمر بوضوح:
“إن هذا ما يعني أنني أعيش لأجل والدتي، وهو أمر غير صحيح، ولكانت أهميتي تتفوق بكثير على واقعي؛ فسأبقى رسولاً للحياة حتى لو لم تربطني بها صلة أخرى غير هذه المهمة […] لذلك فإن لدي غريزة دفاعية لا تسطيع التسامح مع أدنى درجات القبول التي لا تمانع بتحطيم سرير الزواج قبل أن يتم نصبه”.
الشابي العاشق الرومنسي
لم يحطم الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي سرير الزواج مثل كافكا، لكنه لم يكن أكثر حظاً مع الحب، وإن كانت يومياته القصيرة التي تركها تروي عذاباته الكثيرة، النفسية والأدبية والجسدية، فإنها لم تخل من إشارة إلى ذلك الفشل العاطفي الذي تبدى في أعظم تجلياته في قصائده الرومنسية. ولم يكن زواج أبي القاسم الشابي إلا زواجاً تقليدياً، بينما ظل جوعه العاطفي يخفق لنساء أخريات، حال مرضه والواقع التونسي دون أن ينجح، وأحياناً دون أن يولد، ومات في الأرحام. لم يشر الشابي في يومياته ولو مرة واحدة إلى زوجته وابنة عمه التي تزوجها سنة 1929 تلبية لرغبة والده الراحل.
إن استبعاد الشابي لحياته الحميمة في يومياته والاكتفاء بالحديث عن أبيه وعن مرضه أو عن الطبيعة مع تسجيل الأحداث الأدبية، دليل آخر على ذلك الإخفاق العاطفي الذي يعيشه، والذي يشير إليه بالشعور بالكآبة والحزن والوحدة. يكتب يوم الأربعاء 1 كانون الثاني/يناير 1930: “في سكون الليل، ها أنا أجلس وحدي، في هاته الغرفة الصامتة إلى مكتبي الحزين، أفكّر بأيامي الماضية، وذهبت بها صروف الوجود إلى أودية النسيان البعيدة النائية.
أنا جالس وحدي في سكون الليل، أستعرض رسوم الحياة، وأفتكر بأيامي الجميلة الضائعة، وأستثير أرواح الموتى من رموس الدهور. ها أنا أنظر إلى غيابات الماضي، وأحدق بظلمات الأبد الغامض الرهيب. ها أنا أنظر، فأرى صوراً كثيرة تعاقبت على نفسي كغيوم الربيع، وتحركت حوالي كأنسام الصباح، وتعانقت حول قلبي كأوراد الجبل… ثم أنظر فاذا رسوم غامضة مضطربة مقلبة كأمواج البحار، وأطياف ملونة كقوس قزح، جميلة كقلب الربيع تمر أمامي ثمّ تختفي، وتتراقص حولي وتبتعد، ثم تتوارى في أعماق الظلام الدامسة، وأرى أحلاماً صغيرة ناشئة تغرّد كطيور الغابات، وتنمو نمو الأعشاب، وتتفتح تفتّح الورود، ثم تجف وتذبل وتتناثر فتذروها الرياح، ثم تضمحل وتتلاشى في سكون المنون.”.
ويواصل في ذات اليومية استرجاع حياته حتى يصل إلى قوله: “ثم هاهي تلك الريحانة الجميلة التي أنبتتها في سبيلي أنامل الحياة، هاهي تنظر إلي بعينيها الجميلتين الحالمتين كالملائكة، ثم تشير براحتها الجميلة الساحرة وبأناملها الدقيقة الوردية، ثم هاهي تطبع على ثغري قبلة حلوة ساحرة بشفتيها المعسولتين برحيق الحياة”.
لقد كان الشابي يشير دائما في قصائده، كما في هذه اليومية، إلى حبيبة ضائعة غيبها الموت لذلك ظل الموت جاثماً على كل نصوصه بعد ذلك.
جيمس بوزويل، مطارد ‘بائعات الهوى’
لاحق هذا الفشل أيضاً الكاتب الأسكتلندي جيمس بوزويل صاحب “يوميات لندن” الذي عشق الشابة الهولندية ايزابيل دي شاريير، وفشل في حبه كما فشل مع الأرملة جيلفينك التي رفضته زوجاً، وكان قد هام على وجهه في لندن، يلتقط ‘بائعات الهوى’ من أرصفة الشوارع، وكان يصاب كل مرة بعدوى جنسية. أما الممثلة زليدة التي أحبته، فقد تخلص منها برسالة رديئة كتبها من برلين في 9 يوليو، يخبرها فيها أنه أكبر من أن يتزوجها، وأن المرأة التي سيتزوجها يجب أن تحمل مواصفات أخرى، ثم يردف الرسالة بأخرى في 1 أكتوبر فأخرى في 25 ديسمبر قائلاً:
“أيتها الآنسة، إنني رجل متكبر، وسأظل كذلك أبداً. وينبغي أن تفخري بتعلقي بك. ولست أعلم إن كان ينبغي أن أكون فخوراً بالمثل بتعلقك بي. إن الرجال الذين يملكون قلوباً وعقولاً مثلي نادرون. أما المرأة الكثيرة المواهب فليست بهذه الندرة… وقد تستطيعين أن توافيني بتفسير لمسلكك معي”.
وكان يصر على إذلالها وانتزاع الاعتراف بأنها تحبه، وعندما يتراجع ويطلب يدها ترفضه قائلة: “قرأت عبارات إعزازك المتأخرة بسرور، وبابتسامة. حسناً، إذن فقد أحببتني مرة”.
لقد كان بوزيل، الذي كشفت الأستاذة في الطب النفسي بجامعة جونز هوبكنر كاي جايمسون في كتابها “ممسوس بالنار”، أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب والهوس نتيجة نوع من الجنون الوراثي الذي فتك بأخيه، ويعيش تيهاً روحياً، خاصة مع محاولاته المتكررة لتطهير نفسه والإقلاع عن حياة المجون والركض وراء الغواني والعاهرات، غير أن تجاربه الدينية والروحية سرعان ما تنهار أمام رغبته العارمة في العودة لعالم الجنس لأنه لم ينجح في ربط علاقة عاطفية قوية تحصنه من التيه الذي تجسد في رحلاته العديدة التي كان ظاهرها بحث عن المعرفة وباطنها بحث عن النساء.
فريدا كاهلوا تراجيديات عاشقة
تركت فريدا يومياتها في دفتر بعنوان”FK” جمعت اليوميات عدداً من رسوماتها ومخططاتها ونصوص، ولئن دارت معظمها كما عدد من أعمالها الفنية حول الأم المؤجلة أو الأم المعذبة بفشلها في الاحتفاظ بجنينها، فإن هذه اليوميات كانت، أيضاً، صندوق أسارها وحبها لزوجها الرسام المكسيكي دييغو ريفيرا.
لم تكن حياة فريدا العاطفية أقل بؤساً من حياتها الصحية ومعاناتها مع جسدها المريض والمصاب، فقد كانت تعاني طوال الوقت من خيانة زوجها وحبيبها دييغو ريفيرا، حتى وصل به الأمر أن يربط علاقة مع أختها والممثلة ماريا فيليسكس. اليوميات تشير إلى هذا التعلق العاطفي الكبير لفريدا بالرسام، رغم أن فريدا أيضاً كانت لها مغامراتها الجنسية، ويشهد لها البيت الأزرق قصتها مع تروتسكي نفسه.
في أسلوب شعري، كانت فريدا تناجي حبيبها وزوجها دييغو رغم المحن العاطفية التي عاشاها. كان ملهمها وفنانها وعشيقها الأبدي، فتكتب له في يومية:
“لن يعرف أحد كم أهوى دييغو، لا أريد لشيء أن يجرحه، ولا أن يزعجه أحد. ولا أن ينزع منه طاقة هو بحاجة لها ليعيش، يعيش كما يهوى. يرسم كما يرى. يحب. يأكل. ينام. ليشعر بأنه وحده. ليشعر بأنه مصاحب. ولكني لا أريد أن يشعر بالحزن. لو كانت لدي صحة لأعطيتها كلها له. لو كان لدي شباب لمنحته له كله. أنا لست فقط أمه. أنا الجنين. البذرة. الخلية الأولى التي بقوة أنجبته. أنا هو منذ البدء…. ومنذ أقدم الخلايا والتي مع (الوقت) أصبحت هو. ماذا يقول العلماء بهذا الشأن؟”.
إن هذا الشعور الصوفي وهذا الحلول الذي تعيشه فريدا تجسده في إحدى اليوميات عبر حالة من الهستيريا الحروفية حين تنطلق في ترديد اسمه كما لو كانت تنادي إلهاً:
“دييغو
دييغو
دييغو
دييغو
دييغو
[..]
دييغو
تنوع في الوحدة
البدء
الباني
طفلي
حبيبي
رسام
عشيقي
“زوجي”
صديقي
أبي
ابني
أنا
الكون”.
وظلت فريدا على امتداد اليوميات لا تكتب إلا عن دييغو وله، فهو مرة جنينها وهي مرة جنينه. وتخص أحياناً بكتابة اسمه بخط عملاق لتؤكد ألا حقيقة سواه في حياتها وفنها. إنه ماثل في لاوعيها ككون فسيح لا يمكن أن تخرج منه، موحية بدفاعها عنه كل مرة أنه بعيد، ومن هنا يأتي الإخفاق العاطفي الذي ترويه يوميات فريدا. لقد ألّهته حتى تقبل خياناته وحتى لا تلومه وحتى لا تبحث عنه، إنها أعادت خلقه من جديد على نحو فني يتعالق فيه الروحاني بالشبقي دون اشتراط وجوده. فالحبيب الذي يمكن أن نتحمل عذابه ونختلق له الأعذار والأسباب والوحيد الذي نشارك في حبه الآخرين دون خجل ودون إحساس بالنقصان ولا رميه بالتقصير هو الإله. تكتب في آذار/مارس 1953:
“حبيبي دييغو
لست وحيدة بعد الآن
أجنحة؟
أنت ترافقني
أنت تجعلني أنام
وأنت تمنحني الحياة”.
يبدو من خلال تأمل مدونة اليوميات، أن هناك بحثاً عن طهارة ما عند معظم الكتّاب. هناك في داخل كل منهم؛ نساء ورجالاً، مسيح ما بما في ذلك الشخصيات الأكثر تحرراً كأنييس نن، كان في داخلها ذلك الطهوري والمسيح الذي يريد أن يضحي بنفسه من أجل الآخرين، وما بحثها المحموم عن الحب إلا أحد أشكال ذلك الإخفاق العاطفي.
لقد مثلت يومياتها أحد تجليات ذلك الشوق وظلت أنييس تهرب من تجربة الى أخرى ومن زوج إلى آخر حتى وصلت يوماً إلى الجمع بين زوجين. هناك حالة من الجوع العاطفي عندها ربما فُسّرت، أحياناً، برحيل والدها المبكر عنها بعد انفصاله عن أمها، وأرجعت إلى ذلك التشظي الكبير للهوية، حتى أنها لم تقبل أن تقحم تحررها ضمن النشاط السياسي النسوي، واعتبرت أن الحب هو وسيلتها لامتلاك العالم وتغييره. وكما يبدو من التجارب جميعها لم يكن الزواج دليلاً على النجاح العاطفي، بل استمر الإخفاق العاطفي حتى لمن استطاع أن يدخل مؤسسة الزواج، كأندريه جيد وفرجينيا وولف وفريدا والشابي وغسان كنفاني.
رصيف 22
رصيف 22