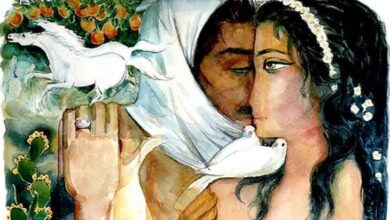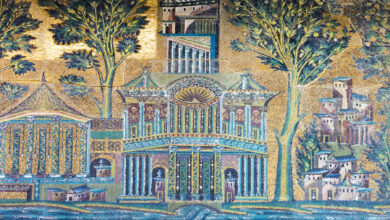مئوية إتيل عدنان: أيّ تدمر في باريس؟/ صبحي حديدي

تحديث 04 أذار 2025
عديدة هي المؤلفات التي تستحق إطراءً خاصاً ضمن لائحة أعمال إتيل عدنان (1925 ــ 2021)، الشاعرة والروائية والتشكيلية السورية/ اللبنانية/ الأمريكية، التي كتبت بالعربية والفرنسية والإنكليزية واليونانية؛ والتي حلّت الذكرى المئوية لولادتها هذه السنة، يوم 24 شباط (فبراير) الماضي. للمرء أن يُعجب بمجموعاتها الشعرية، أو بسردها عموماً وشهادتها الروائية عن الحرب الأهلية اللبنانية خصوصاً، أو بنصوصها الفلسفية التي تجمع بين التأمل الحرّ والتوجّه التعليمي الأكاديمي، أو الانهماك التشكيلي الذي تجاوز الإضافة الفردي إلى التجريب التأسيسي؛ أو نماذج من هذه الفنون جميعها، مؤتلفة ومتّسقة ومتكاملة…
وفي خمسينيات القرن المنصرم، حين نشرت قصيدتها الطويلة الأولى «كتاب البحر» باللغة الفرنسية، لم تُعلن عدنان سلسلة الجدليات التي سوف تندرج تباعاً في نتاجاتها، حيث تفاعلات الثقافتَين التركية والعربية والإسلامية (مزيج الأب، الضابط العثماني)، والمسيحية/اليونانية (من الأمّ)، فحسب؛ بل تجلّت بوضوح تأثيراتٌ مبكرة، مختلطة بدورها ومتفاعلة، لأشعار شارل بودلير وفردريش هولدرلن وأرتور رامبو. ومن دراسة في جامعة السوربون الفرنسية إلى تدريس الفلسفة في سان فرنسيسكو، كانت مسارات جديدة تنتظر الشاعرة الفيلسوفة التشكيلية.
بيد أنّ ذلك الجدل الثقافي واللغوي والجغرافي لم يخلُ من استيلاد عوائق جوهرية نجمت أساساً عن اصطراع تلك الخلائط، مقابل إيجابيات شتى عديدة أكسبت نصوص عدنان حيوية بالغة الخصوصية، ونضارة تعبيرية انبثقت بدورها من استجماع حساسيات الأمكنة والخلفيات الوجدانية والمكوّنات البصرية. ولعلّ المثال الذي اعتادت عدنان الإشارة إليه، بروحية تجمع الأسى بالتسليم، هو في عداد الأبرز على ما جابهته نصوصها من إشكالية مركبة.
أليس من المحزن، تساءلت الشاعرة، أنّ «كتاب البحر» قصيدة تعزّ على الترجمة إلى اللغة العربية، لا لشيء إلا لأنّ البحر مؤنّث في الفرنسية بينما هو مذكّر في العربية؛ الأمر الذي يمكن أن ينسف البُعد الإيروتيكي الأهمّ في القصيدة؟ هذه بالطبع بعض أكلاف العيش في ما نسمّيه عادة «منفى اللغة»، إذْ تعتبر عدنان أنّ منفاها «يعود إلى حقبة سابقة بعيدة، ويمتدّ زمناً طال كثيراً، حتى صار طبيعتي الخاصة».
وفي سياقات أخرى أكثر التفاتاً إلى نتاج عدنان الإجمالي، يهمّ هذه السطور التوقف عند كتاب صغير، مجهول نسبياً، بعنوان «باريس، حين تكون عارية»؛ صدر بالإنكليزية سنة 1993 ضمن منشورات Post-Apollo في سوساليتو ــ كاليفورنيا، حيث أقامت عدنان (نقلت ميّ مظفر الكتاب إلى العربية تحت عنوان «باريس عندما تتعرى»، دار الساقي، 2007). ولعلّ خصوصية هذا الكتاب أنه، بادئ ذي بدء، يستعصي على التصنيف الأنواعي؛ فتضعه لوائح أمازون، مثلاً، ضمن الرواية، لا لأيّ اعتبار آخر سوى أنه يصعب إدخاله في خانة المذكرات أو الشعر أو السرد، رغم أنه يجمع الكثير من عناصر هذه الأجناس الكتابية.
الكتاب، حسب الأصل الإنكليزي، يقع في 115 صفحة، تتوزع على 34 فصلاً متوسطة الحجم، يكرر كلّ منها عنوان الكتاب ذاته؛ وتتوغل عميقة متمهلة تارة وانطباعية متعجلة تارة أخرى، في العشرات من عناوين مدينة باريس: الحدائق، الشوارع، محطات المترو، المقاهي، التماثيل، مظاهر العيش والحياة اليومية… وهنا معادلة الكتاب الأدهى، أو الأبهى بالأحرى، لأنّ القارئ لن يخرج بحصيلة أحادية الجانب سياحية المقاربة عن مدينة متلاطمة المشاهد، طافحة بتواريخها المحلية والكونية، ولكن أيضاً بتواريخ ساكنيها من جنسيات لا عدّ لها ولا حصر.
وكي تُنصَف عدنان، المواطنة نصف السورية على الأقلّ، في مناسبة مئوية تتصادف أيضاً مع دخول بلدها في طور ما بعد «الحركة التصحيحية» و54 سنة من دكتاتورية الأسدَين الأب والابن، حيث هيمن نظام الاستبداد والفساد وجرائم الحرب ورهن البلد لخمسة احتلالات بعد تدمير قسط هائل من عمرانها ونسيجها الوطني والاجتماعي؛ تصّح الإشارة إلى ما احتواه كتابها عن باريس من إشارات إلى سوريا، تنضح بمشاعر الانتماء ولا تتعفف عن إبداء الحنين، ولا تتجاهل حوليات التاريخ.
وإلى جانب مزيج من الحزن والغضب إزاء عجز عدنان عن توفير الماء والعزاء لسجين سياسي سوري، على مبعدة أمتار من أجراس كنيسة سان سولبيس التي تُقرع، كما تقول؛ فإنها تشدد على أنّ المدن «جمعية سرّية» لا يستطيع المرء التورّط مع واحدة منها بمعزل عن الانخراط في الأخرى. ما العلاقة بين باريس وحلب مثلاً، تتساءل عدنان قبل أن تجيب: ها أنّ المرء يتنفس الرفض هنا، أفلا يتنفس الاغترابَ في مدينة سورية شمالية؟ وتكتب: «أنا أطرق مسارب عديدة في آن معاً: أقف أعلى قلعة حلب إذْ أتوقف أمام شارة السير الحمراء هذه، معرّضة للبلل، كأنني أذرع شوارع بيروت حيث تثور عاصفة ثلجية».
وأمّا الشرق، في كتاب عن واحدة من كبريات حواضر الغرب، فإنه يستدعي عند عدنان هذه السطور من شعر هولدرلن: «أنتِ، يا مدن الفرات/ وأنتِ، يا شوارع تدمر/ يا غابات الأعمدة في وجه الصحراء/ ما الذي حاق بك؟». فتستذكر «الشرق الخاصّ بي، حجارة دمشق العتيقة، بل حتى حجارة روما. نعم، لأنّ باريس مدينة شمالية، ذات ثقافة متوسطية، ولهذا فهي مكان يبعث على الجنون».
.. ويربط بين باريس وتدمر، ولا يستثني قلعة حلب وأوابد دمشق!
القدس العربي