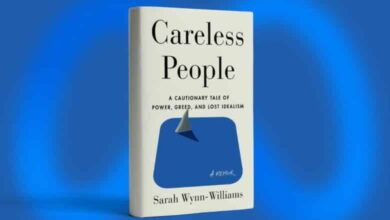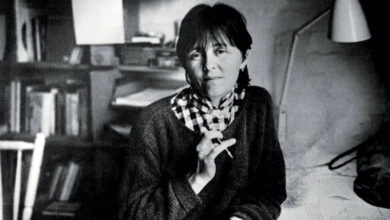ثلاث مراجعات لكتاب ” إدوارد سعيد… أماكن الفكر”/ تيموثي برينان

ما لم يقله إدوارد سعيد في «خارج المكان»
الكتاب الوحيد الذي سطره مستخدماً صيغة الـ«أنا»
بيروت: سوسن الأبطح
تعود سيرة إدوارد سعيد المثيرة إلى الواجهة. فهو بذكائه استطاع أن يبرع في تشريح شخصيته، وإبراز تعقيداتها وتناقضاتها، من خلال مهاراته النقدية الفذة، وجعلها باستمرار مشتهى لإعادة القراءة.
فقد أصدرت سلسلة «عالم المعرفة» مؤخراً كتاب «إدوارد سعيد… أماكن الفكر» لـ تمثى برنن، ترجمة محمد عصفور. وهو عبارة عن أول سيرة كاملة لرائد دراسات الاستشراق الجديد، وما بعد الكولونيالية. والمؤلف برنن هو أحد تلاميذة إدوارد سعيد، الذي ظل صديقاً له حتى وفاته عام 2003. قبل عامين قدمت مؤسسة «ثمانية للنشر» فيلماً وثائقياً عن حياة سعيد بعيون أسرته. وقبل أيام أعادت إذاعة «فرانس كولتور» الفرنسية، بث مقابلة كانت قد سجلتها مع سعيد، بمناسبة ترجمة سيرته «خارج المكان» التي صدرت عام 1999 إلى لغة موليير، يتحدث خلالها بفرنسية متقنة، عما لم يقله في الكتاب.
الكتاب المحور
و«خارج المكان» هو الكتاب الوحيد لسعيد الذي سطره بصيغة الأنا، وقبله سجل مقاطع مختزلة لذكريات قصيرة ومتقطعة، لكنه هذه المرة وجد نفسه أمام اختبار كتابة نص مكثف وطويل، يعتمد في منهجيته، على غزير قراءاته للسير الغربية، التي نهل منها باكراً.
يقول سعيد للإذاعة الفرنسية «كتبت في سيرتي عن ثلاثة عوالم جميعها اختفت. أولها طفولتي التي انتهت في فلسطين قبل أن توجد إسرائيل، ومصر قبل ثورة جمال عبد الناصر عام 52، ولبنان قبل الحرب الأهلية 1975. كان الأمر صعباً لأن أمي هي صلتي بكل هذه العوالم، وقد توفيت عام 1990». بعد وفاتها بعام واحد فقط، عرف إدوارد أنه مصاب بسرطان الدم. ثلاثة تحولات على الأقل حدثت في تلك الفترة، وربما أنها ثمرة مراجعاته الذاتية التي أجراها، بعد أن بقي في المنزل يتلقى العلاج، ويعيد قراءة أحداث مساره الذي تأرجح بين مدّ وجزر، أولها انكبابه على كتابة سيرته.
تحولات ما بعد المرض
وثانيها أنه بعد معرفته بالإصابة بعام واحد، قرر أن يصطحب زوجته مريم وولديه للمرة الأولى إلى فلسطين ليريهما أرض الجذور وبيت العائلة الذي تركه عام 1947، ولم يعد إليه أبداً. كانت تلك زيارته الأولى. جال كثيراً باحثاً عن البيت في حي الطالبية في القدس الغربية. تغيرت الملامح كلياً وأصبحت الأسماء عبرية. بدا محبطاً وهو يبحث ولا يجد. في النهاية عثر على البيت بفضل معونة رجل مسن. وجده كما هو. كان يظن أنه لا بد قد اُحتُل من عائلة يهودية، وللمفاجأة كان قد تحول مركزاً إنجيلياً أسسه متطرف يؤمن بالصهيونية، آت من جنوب أفريقيا. تردد سعيد في الدخول. توتر، صار يمشي جيئة وذهاباً، وفي النهاية قرر ألا يدخل.
بعد تلك الزيارة، صار يذهب إلى فلسطين مرة في السنة على الأقل، ومع أنه كان متابعاً حثيثاً للأخبار هناك، إلا أن زياراته ورؤيته للأرض، خاصة اكتشافه عدد الفلسطينيين في الجليل والناصرة والقدس، أقنعه أن حلّ الدولتين، غير ممكن على الإطلاق، واتخذ موقفه النهائي والحاسم، بأن لا حل سوى بدولة واحدة يعيش فيها الجميع.
بعد مرضه أيضاً، أصبحت الموسيقى في حياة سعيد حاضرة طوال النهار، تصدح في البيت دون توقف. وهو ما جعل اللقاء بينه وبين الموسيقي الأرجنتيني – الإسرائيلي دانييل بارينبويم، ممكناً أكثر من أي وقت مضى، وأنشآ معاً مشروع «ديوان الشرق والغرب» والأوركسترا التي ضمت عازفين عرباً ويهوداً، في مقاومة فنية للعدوان.
مفصل 1967
لم يتوقع سعيد النجاح الذي حصدته الأوركسترا، كان فخوراً بها للغاية، وعدّها بعد ذلك أهم مشروع قام به في حياته، بحسب زوجته.
في حديثه لإذاعة «فرانس كلتور» يقول سعيد، إن النكبة ورحيله عن فلسطين عام 1947 لم تصبه بصدمة كبرى؛ ذاك أن الأمور حدثت بالتدرج، وعائلته كانت قبل ذلك، تتنقل بين مصر وفلسطين، وكان يرى الجنود الإنجليز حول بيته، ويشعر بالاضطرابات. لكن التحول الفكري الكبير كان بعد 1967، حيث كان في نيويورك، وشهد ذاك الانتشاء بالانتصار الإسرائيلي على العرب. «علمت بكل ما يحدث وأنا في أميركا كضحية معذبة، لم أكن قادراً أن أبقى مجرد أجنبي. بدأت أكتشف ماذا يعني أن أكون عربياً وفلسطينياً». عاش في أجواء مناهضة حرب فيتنام دون كلمة عن فلسطين. يقول، إنه لم يكن قادراً على الانخراط في المجتمع الأميركي، له حياة علمية في الجامعة، لكنه على المستوى الشخصي مهمش. هذا ما أجج لديه، شهية البحث عما حدث في القرن التاسع عشر، وبرر الاستعمار، وكيف يؤثر هذا الفكر على حاضر العرب.
محطة ستدفع به إلى مزيد من البحث حول الأفكار الجاهزة التي تقولب التفكير الغربي، وحاجته إلى ما يزلزله. ومن هنا جاء كتابه «الاستشراق».
طفولة في العزلة
إدوارد سعيد وُلع بالحديث عن سنينه الأولى، عن أمه ومشاعرها القومية العربية، التي لازمها ولم يكن له في طفولته أصدقاء. تأثر بعاداتها، قيمها، قلقها، وحبها للجمال، الموسيقى الفن، الأسلوب الجميل، وبقيت ذات تأثير كبير على شخصيته، وإليها يعزو حسه القومي والوطني الفلسطيني. فوالده رجل الأعمال الفلسطيني الذي كان يعدّ جنسيته الأميركية مفتاحاً سحرياً، أراد لولده الوحيد أن ينشأ غربياً مكتملاً. وكل معارضة له «يمكن أن تجعله ينفجر كبركان». قال له ذات مرة لينهيه عن التفكير في السياسة. «فقدنا كل شيء، وما عاد بمقدورنا فعل شيء، من الحكمة الاهتمام بالحاضر والمستقبل».
برغبة من الأب عاش سعيد في مدرسة إنجليزية، تحرّم عليه استعمال العربية. لكن والدته كانت تحدثه بلهجتها نصف اللبنانية. «تركت معرفتي باللغة والأدب العربيين، وركزت على الأدب الغربي، لم يعد عندي الوقت».
الحياة بين لغتين
يقول في مقابلته الإذاعية «حتى العشرين من عمري كان الانتقال بين اللغتين حملاً ثقيلاً، باستمرار». لكن بعد حرب 1967 بأربع سنوات، «أدركت أنني لو أردت أن أشارك في النضال من أجل فلسطين عليّ أن أجيد العربية». انتقل إلى بيروت وأمضى عاماً كاملاً يتعلم العربية التي نسيها. خلال هذه السنة تعرف على زوجته الثانية مريم في بيروت وتزوجا عام 72، وهي السنة التي سيتردد فيها على أنيس فريحة، صديق والده يومياً من السابعة إلى العاشرة صباحاً ليعلمه العربية، وبعد ثلاثة أشهر من التعليم سيبدأ يقرأ ابن خلدون، وطه حسين والغزالي، ومحفوظ، ويكتشف أنه نفسه لا يعرف ثقافته، فكيف يدّعى المستشرقون الغربيون تلك المعرفة؟ ولماذا يتعاملون مع هذه النصوص كجثث محنطة؟
رفض سعيد أن يصبح مجرد خبير كالأكاديميين الأميركيين في مراكز الأبحاث، يدّعون الاستقلالية، لكنهم في العمق، يكرّسون كل معارفهم، لخدمة أحد الحزبين الكبيرين، الجمهوري أو الديمقراطي. قرر أن يكون مستقلاً، وأن يخرج على تقاليد العائلة التي تأنف من العمل السياسي. فوالده أصبح مريضاً وهو صار حراً. ومع ذلك لم يقبل أبداً، أي منصب أو عمل سياسي. «كانت بالنسبة لي خدمة فلسطين والفلسطينيين أهم من أن أكون قائداً. ربما أنها فكرة بروتستانتية».
أنفة من السياسة
سعيد يأسف لأنه ينتمى إلى عائلة، بل طبقة مسيحية عاشت في مصر أقرب إلى المستعمر الإنجليزي منها إلى الناس. «عشنا معزولين مع أناس مثلنا أرمن، سوريين، وغيرهم. هي طبقة تعيسة؛ لأنها لم تفعل الكثير لمصر، لم تسهم بالمعنى الثقافي». أما في فلسطين، فكان من طبقة «تبنت فكرة أن السياسة لا يصنعها الناس وإنما السياسيون والطبقة السياسية، ونحن أقلية، ولا شأن لنا بالأمر». حتى بعد 67 حين انخرط في الاهتمام بالقضية الفلسطينية، «والدي وحتى أمي لم يكونا موافقين، أبداً. كان والدي يقول لي هذا ليس شأنك، أنت مثقف وأستاذ جامعي، دع السياسة للسياسيين. إنك تتبع فكرة خاطئة».
أعجب إدوارد سعيد بياسر عرفات كبيراً، لكنه اختلف معه، ورأى أن أوسلو كانت خطأً كبيراً. كان بمقدور الفلسطينيين أن يتسلحوا بخرائط وأدوات أفضل، وأن يتنازلوا أقل. في أوسلو عدّ أن مسألة الانسحاب الكامل كان يجب أن تكون البند الأول، وهو ما لم يحصل، فوصف الاتفاقية التي وقعت بأنها كانت «استسلاماً».
تناقضات مؤلمة
تمنى دائماً لو يكون له تأثير سياسي أكبر. كان عضواً لفترة في المجلس الوطني الفلسطيني، وعمل مفاوضاً مع البيت الأبيض، لكنه سرعان ما استقال. بقي باستمرار معجباً بالمناضلين السياسيين، الذين لم تؤهله تربيته، ولا بيئته أن يكون واحداً منهم.
كان إدوارد يتمنى الكثير مما لم يعشه. كان متطلباً، ولم يشعر بالرضا. يقول عنه تلميذه تمثى برنن «إدوارد صاحب روح معذبة. قضى ردحاً طويلاً من حياته يتعالج عند محلل نفسي، ويتردد على العيادة بشكل مكثف، لمرتين في الأسبوع».
وهو ما يلمح إليه في كتابه «خارج المكان» دون الدخول في التفاصيل. لكن قد يكون هذا القلق، هو وراء الحيوية الفكرية العارمة التي عرف بها إدوارد سعيد، وخلف مواقفه وكتاباته الجريئة التي تميزت بها العقود الثلاثة الأخيرة من حيا
الشرق الأوسط
——————————————-
تلميذ إدوارد سعيد يكشف الجانب الذي غفل عنه قراء أستاذه/ ممدوح فراج النابي
تمثي برنن يعيد كتابة سيرة المفكر العربي ورسم صورته الدنيوية.
يعد المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد (2003-1935)، نموذجا هاما للمثقف العضوي لو استعرنا مفهوم غرامشي، إذْ قدم تمثلا حقيقيا للمثقف غير المتعالي والمتشابك مع قضايا الجماهير، دون التقليل من إسهاماته المتعددة في كافة المجالات؛ النقدية (وتحديدا النظرية) وتحليل الخطابات المعرفية التي تناهض الذات؛ لذا تعد سيرة حافلة بصور شتى عن الأنا في تشكلاتها من أجل اكتشاف هويتها ووجودها، فصارت سيرته المترعة مجالا رحبا (من قبل الباحثين والتلاميذ والمريدين) لاستحضار شخصيته للوقوف على هذه الأنوات المتعددة المتصارعة.
كانت سيرة إدوارد سعيد نموذجا خصبا لما يمكن أن نطلق عليه دراسة “التكوين الفكري لحيوات المفكرين والكتاب”، وهو ما أسهم في تشكيل بنى هذه العقلية، وما صاحبها من تحولات منهجية وفكرية، ولم يبخل علينا إدوارد بكتابة سيرته التي كانت أشبه برواية تجاوزت حدود التصنيف الموضوع على غلافها “مذكرات”، فقدم واحدة من أروع السير الذاتية التي سعت إلى فض تشابكات الأنا مع الآخر، بدءا من حل صراع وتوتر ازدواجية ثنائية اللغة (العربية الأم – الإنجليزية لغة الدراسة والاستعمال) في سبيل البحث عن الهوية المضطربة (أو المنشطرة) التي عاشها بإحساس إثنينْ داخل شخص واحد، وهو ما تبلور في صورة غربة مزدوجة كان يعيشها، وهي السيرة التي عرفت بـ”خارج المكان” (2000)، والتي كان حريصا في كتابتها لتجسير “الهوة التي تفصل بين عالمينْ نقيضين؛ عالم البيئة الأصلية (الماضي) والتربية (حاضره)، أو حيرة الأنا – الأنا، فسعيد لازمه إحساس قديم منذ “أنْ رحل قسريا من بلدته فلسطين، وأقام في مصر بأنه كان يعد غريبا في القاهرة لأنه أميركي، أما بلده الأميركي فلم يعده أصيلا فيه”، هذه هي المحنة التي أرقته، وهي ما تجسدت بشكل عملي عندما رفض صعوده على رحلة الطائرة في البرتغال، فشعر بالإهانة رغم أنه أشهر هويته الأميركية.
فليس الهدف هنا – كما يخال البعض – هو إعلان القطيعة أو العداء بين ما كان وما هو كائن، أو ما أراده ولم يكن، وإنما الهدف هو إبراز التفاعل الثقافي الذي لمسه الكاتب في هويته التي لم تتشكل، كما يرى، في صيغة أكثر تناغما بين الذاتين المتقاطعتين؛ العربية والأميركية. وكان لثراء الشخصية، وعطائها الفكري اللامحدود، أن تعددت السير (الغيرية) التي كتبها مقربون منه، أو زملاء عاصروه، لكن تبقى السيرة التي أصدرها تلميذه تمثي برنن “أماكن الفكر” (الصادرة عن سلسلة عالم المعرفة (عدد 492، مارس- 2022)، بترجمة محمد عصفور؛ واحدة من أكثر السير التصاقا بإدوارد سعيد، بل تكاد تكون بمثابة قراءة غير مباشرة لفكر سعيد، وكذلك تأويلا جديدا لمذكراته “خارج المكان”، حيث تعامل تمثي معها وكأنه يعيد قراءة خارج المكان، ولكن عبر مصادرها الأساسية وليس حسب راويها الأصلي، فأهم ما في كتاب تمثي هو أنه يرصد السياقات المختلفة التي تمت فيها كتابات إدوارد سعيد المتعددة، فهو يضعنا في أجواء ثقافية حماسية وصراعات سياسية وفكرية كانت الخلفية الأساسية لانبثاق الأفكار الرئيسية لهذه الأطروحات.
السيرة الدنيوية
لا جدال أن إدْورْد سعيد (حسب الهجاء الجديد الذي ابتغاه مترجم الكتاب) يعد واحدا من أهم المفكرين الذين غيروا نمط التفكير في نص القرن الأخير، وهذا على أكثر من مستوى، أولا على مستوى التنظير النقدي، برقش النظرية وتتبع ارتحالاتها، وهو ما أسفر عن استحداثه النظرية الطباقية في قراءة الأعمال الأدبية، أو النقد الدنيوي، وقبلها بتسليط الضوء على الاستشراق، وتقديم جهد لافت في قراءة المشروعات الاستشراقية وكشْف أغْراضِها، وسعيه إلى تصحيح الصورة المغلوطة التي رسمتها المخيلة الاستشراقية عن الشرق.
وثانيا بما فعله للقضية الفلسطينية، ودفاعه المستميت عنها، سواء بالكتابة عنها أو بشروعه في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية من الاندثار بعمل أرشيف يحتوي على الآلاف من الصور الفلسطينية منذ عام 1948، وكذلك بالدفاع عنها في الصحافة الغربية والمحافل الدولية، والتخطيط السياسي وتحمله لسهام النقد والهدم التي وجهت إليه من قبل الأصدقاء قبل الأعداء، فظل متمسكا بالدفاع ضاربا أروع الأمثلة بنموذج المثقف الفاعل لا المنعزل في برجه العاجي، بصفته – كما يقول تمثي – “الضمير الاجتماعي في المجتمع، ومشخص أمراضه، وواضع أجندته”، فأسهم بشكل غير مباشر إلى نقل العلوم الإنسانية من الجامعة إلى مركز الخريطة السياسية.
كما تعددت الأعمال التي قام بها، والتي جعلت منه نموذجا للشخصية الكوزوموبوليتانية في رحابتها وتعددها وانفتاحها، على نحو ما كانت هويته الحقيقية متعددة بين ثقافات وعرقيات مختلفة، وإحساس المنفِي الذي طارده منذ طفولته، كل هذا جعل شخصية سعيد المترعة، ذات تركيبة معقدة بعض الشيء، وفي الوقت ذاته ثرية، إلا أنها صعبة القولبة أو التدجين ووضعها تحت إطار عنوان واحد؛ فهو المناضل المحارب، وهو الناقد الحصيف، وهو صاحب النظرية، وهو الإنساني وهو الموسيقي ، ولك أن تضع ما تشاء من الألقاب التي تتسم بها الشخصية التي هي نتاج عوامل كثيرة، ليس أهمها المنفى أو الارتحال التي عبر عنها مرارا وتكرارا بمشهد الحقيبة الجاهزة للسفر، في مذكرات خارج المكان.
ثمة جانب غفل عنه كل من قرؤوا سعيد عبر كتاباته، فكما يقول تلميذه وكاتب سيرته تمثي برنن لم يروا كل ما فيه: “لم يروا صبيانيته بلا شك مثلما لم يروا ولاءه العميق لأصدقائه وتسامح هؤلاء مع قدر من السلوك السيء: الاعتداد بالنفس، والنزق الذي يظهر أحيانا، والحاجة المستمرة إلى الحب والدعم المعنوي”، هذه الصورة المـقربة التي يقدمها كاتب السيرة الغيرية، تكاد تكون مبْعدة أو مقصاة أثناء كتابة السيرة الذاتية.
فصاحب السيرة الذاتية مهما ادعى قول الصدق وفقا للميثاق السيري، إلا أن ثمة عوامل عديدة تحول دون تحقيق الصدق الخالص، وأهمها عامل الاختيار والانتقاء، فمثلا إدوارد سعيد لن يحدثنا عن نزق طفولته في خارج المكان، أو عن أنانيته بأن يذهب إلى حفل موسيقي ويترك ابنه المريض، بل كل ما يركز عليه هو التكوين الاجتماعي وكيف تشكل فكره وصراعه بين الهوية (المضطربة على حد وصفه) والانتماء إلى الوطن خاصة في ظل التمييز الذي لاحقه وهو في المدرسة، كان جهد إدوارد سعيد في مذكراته هو الوصول إلى هدنة مع الذات المرتحلة مكانيا وثقافيا وعرقيا، ووضعية هذه الذات في خضم صراعات متعددة، لا تقف عند الصراع الكبير: صراع بين الشرق الغرب، أو صراع بين المركز والهامش، وإنما صراع بين اللغة العربية والإنجليزية.
لئن كانت سيرة إدوارد التي كتبها بنفسه “خارج المكان”، هي سيرة – في مجملها – توفيقية بين الهويات المتصارعة على مستوى الأنوات والأمكنة والثقافات واللغات؛ فإن السيرة الغيرية (إذا استعملنا المصطلح العلمي الدقيق) “أماكن الفكر” التي كتبها تلميذه تمثي برنن هي السيرة الذاتية الكاملة، أو الأقرب إلى الكمال؛ فهي سيرة عن إدوارد سعيد الإنسان والمفكر والمناضل، صورة جامعة وشاملة لنواحٍ عديدة من حياته الشخصية، وطفولته وعلاقاته بأفراد أسرته المتوترة، وعلاقاته بأصدقائه، في غضبه ومزاحه.
كما كتب برنن حياة سعيد البوهيمية وهو يتسكع لمشاهدة الأفلام السينمائية، وعن إخفاقات الزواج، وعن العمل وأصدقاء العمل، عن المنهج والبحث عنه؛ عن سعيد في طبيعته وهو يلح على أصدقائه لشراء ملابسه وأحذيته، وعن طعامه، وهواياته، بالأحرى هي سيرة عن سعيد الإنسان الأرضي، بعيدا عن حيل التفاوض التي استخدمها سعيد ليصل إلى هذا الإنسان المزيج بين أناتيْن متناقضتين؛ الأنا العربية والأنا الأميركية، أو العائش بين عالميْن غير مريحيْن بتعبير زوجته (الأولى) مايرة في رحلة استعادة الطفولة وأماكن النشأة والتكوين؛ أي صورته التي جعلته أيقونة بالمعنى الحرفي للكلمة، وأن يبقى دائما في عالم الأفكار وعلى استمراريته بعد التغيرات التي تحْدث مع تعاقب الأجيال، كما شهد له أعداؤه من أمثال “جوشوا مور”.
سيرة غيرية
يرسم كتاب “أماكن الفكر” صورة لإدوارد سعيد الدنيوي إن استعرنا مصطلحه عن النقد الدنيوي، حيث يرسم “صورة كاملة لشخصيته العربية والأميركية وهما تتحدان”، بل هو كتاب تأويلي، على أكثر من مستوى؛ فهو تفسير لصراعات الهويات والشخصية المضطربة في “خارج المكان”، وتفسير لحيرة الأنا (العربية) – الأنا (الأميركية)، وأيضا يمكن اعتباره تفسيرا لـ”كتابات سعيد عن فلسطين والموسيقى، ومفكري المجتمع، والأدب، ووسائل الإعلام”، والأهم تفسير الدور الذي لعبته الأم في تشكيل وعي الطفل، باعتبارها الحاضنة التي نهل منها من كل شيء بما فيها انتماءاتها السياسية، وهي تتحدث عن القومية العربية، أو حتى باعتبارها قاعدة بيانات للذاكرة الفلسطينية، وحفظها لبيانات ضخمة عمن غادر فلسطين ومتى في حرب 1948.
تحضر سيرة “خارج المكان” (إلى جانب كتابات سعيد النقدية والفكرية) داخل المتن هنا. فالراوي السارد يحكي عن انزعاج أخوات إدوارد من الصورة التي رسمها سعيد لأبيهم في سيرته. فعلى عكس الصورة التي رسمها سعيد للأب وصوره بأنه أب قاس متصلبٌ وجاهل في الأمور العاطفية، بدا لهن الأب “هادئا رقيقا عاملهن بالحب والعطف، وأنه حمل جين (أخت سعيد) في حضنه طول الليل عندما أصيبت بالمرض، وغنى لها، ولاعبها بالحيل السحرية”.
الصورة النقيضة التي رسمتها الأخوات للأب في “أماكن الفكر” تكشف حالة الذات المتوترة التي كان عليها إدوارد في كتابته لسيرته، وبمعنى أدق تكشف عن الهوة التي كانت بين الأب والابن، لا على مستوى المكان، فالابن أرسله الأب إلى مدارس داخلية، ثم أرسله إلى أميركا، وإنما على مستوى العلاقات العاطفية، وتحديدا علاقته المؤلمة مع الأب المتسلط؛ فقد نشأ بينهما جدار عاطفي، لم يكسر حواجزه إلا مرض أبيه، على عكس البنات اللاتي حكين صورة تكشف عن القرب العاطفي، فالحضن في حد ذاته أكبر دليل على الدعم المعنوي، وهو ما كان يفتقده إدوارد، وهو ما رسخ عنده حب العزلة، والهروب من أصدقائه في كلية فكتوريا.
ومن ثم من الضروري قراءة الكتابين في مواجهة معا لمن يريد أنْ يفك الاشتباك بين ذات سعيد المضطربة في “خارج المكان”، وذات سعيد المطمئنة الهادئة في “أماكن الفكر”، ففي الكتاب الثاني “أماكن الفكر” تحليلات لما كان مر عليه سعيد في مذكراته دون تبرير أو تعليل؛ فيرد العزلة إلى الالتصاق الشديد بالبيانو، وإن كان خلق عزلة على مستوى سعيد، فإنه -في المقابل – كان وسيلة انتماء لأفراد العائلة، فالأطفال الخمسة كانوا يعزفون لمدة طويلة، وأيضا كانت الموسيقى إلى جانب القراءة هي المصدر الرئيسي لانضباطه الفكري والخيالي. وأول نظرية يستقصيها قبل أن تهيمن عليه الفلسفة.
أهمية قراءة تمثي لسيرة إدوارد سعيد (الذاتية والفكرية) إذا اعتبرنا أن ما كتبه هو قراءة طباقية بالمعنى الذي قصده إدوارد سعيد (والتي استوحاها من التوزيع الموسيقي الهارموني)؛ أي قراءة النص وفي الوقت نفسه قراءة النصوص الأخرى التي تتداخل معه؛ تكمن في أنه يمكننا قراءة ما كتب في ضوء التاريخانية الجديدة، أي الجمع بين السيرة الذاتية الشخصية لإدوارد سعيد في ضوء الوثائق والمقابلات التي قام بها تمثي برنن، والسياق الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي نشأ فيه سعيد، وبالتالي قراءة واقعينْ بكل تمظهراتهما الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، يتمحوران بين هنا وهناك، وما كشفه من تفاعل مؤثر بين الذاتي والعام، فسيرة إدوارد (الذاتية والفكرية والعملية) هي نتاج لسياقات عصره بكل تحولاته وتمظهراته.
يتتبع برنن في كتابته للسيرة زمنا كرونولجيا، يبدأ بتتبع مسيرة هذه السيرة منذ الطفولة، مرورا بالمراحل المختلفة، بما فيها الحياة الجنسية بعيدا عن مراقبة الأم، وفي تتبعه لهذه الآلية، يتوقف عند المواقف التي تكشف شخصية سعيد، فنراه يقف عند علاقاته الشخصية بأفراد أسرته، ونظرة أخواته البنات له، وتعامله هو داخل البيت، في الفصل الأول الذي جاء بعنوان “الشرنقة” يتحدث عن طفولة سعيدة والحادثة التي تعرضت لها الأم بفقدانها ابنها الأكبر من إدوارد، وخشية الأسرة أن تتكرر مأساة فقد الطفل، فقررتْ أن تعود إلى فلسطين، وبدلا من الاعتماد على دكتور تم التوجه إلى قابلة في تناقض للحالة الأولى، وتناقض لوضعية الأسرة الاجتماعية والاقتصادية، التي كان الأب عمودها الأساسي في عيد الشكران يتناول ديكا روميا.
يسهب السارد في توضيح النمط الحياتي الذي عاشته أسرة سعيد، وانعكاسات ذلك عليه، بما فيها من محاولات الأسرة إبعاده عن السياسة، إلا أن تأثيرات أفراد العائلة تسربت إلى عالمه المثالي، ومهدت ليقظة سياسية، كحب العمل التطوعي مثلا.
الخروج من الشرنقة
الشيء المهم في سرده لهذه الرحلة الطفولية التي كانت بمثابة الخروج من الشرنقة، لما اقتضته من عوامل بيداغوجية أسهمت في صقل وعيه وتشكيله؛ أنها توقفت عند مفاصل أساسية في تكوينه، وكانتْ فِعلا بمثابة الضوء أو البصيرة للكثير من التحولات في شخصية إدوارد سعيد، فسيرة “أماكن الفكر”، يمكن اعتبارها بصورة أخرى سيرة الإجابة عن سؤال لماذا في حياة سعيد وتركيبته، ومواقفه النقدية والسياسية وأيضا مواقفه الأخلاقية التي حتمها وضعه كمنظر نقدي سعى إلى توسعة النقد إلى ما بعد الأدب الإبداعي، وموقفه من الدين، الذي لا يتعارض مع كونه علمانيا؟ فالدين في رأيه “مسألة اختيار وإيمان”.
وأيضا إجابة عن: لماذا (كمفكر) اهتم بقضايا الإنسان المهمش، والهجنة والجندر، والتابع والمستعمِر، وغيرها من قضايا طرحتها الدراسات الكولونيالية؟ ومن هنا أبرزت السيرة إجابات عن تحولاته النقدية واشتغالاته الفكرية، وتبلورت علاقته بالسياسة التي جاءت على استحياء في بادئ الأمر، ثم تطورت بعد أحداث الأعوام الشداد الخمسة بأن انخرط فيها بقوة محطما الخيط الحذر الذي رسمته له العائلة في هذا الشأن، ثم علاقاته بإقبال أحمد وإعجاز أحمد الهنديين، وفانون وغيرهم من رجال فكر كانوا يناضلون من أجل أوطانهم؟ وكيف تبدلت نظرته للواقع في خطابه وأولويات اهتماماته؟ وكأننا أمام صحوة أدخلته في معترك الأنا الجمعية، ومن ثم لم يتوان عن جلد ذاته، وهو ما صاغه في مقالة “صورة العربي”.
حالة الاضطراب أو عدم الانضباط (بتعبير أبيه) التي كان عليها إدوارد وهو في القاهرة، لازمته وهو في أميركا، وصارت توصف بعدم الاستقرار، على الرغم من حصوله على الجنسية الأميركية، فالصراع بين الأنا (هنا)، والأنا (هناك) بدأ يزيد، وهو ما تبلور بصورة جلية في “خارج المكان” رغم أن سعيدا في بعض الأحيان كان يشير إلى الانتماء إلى الهناك/ أميريكا، في تأكيد لحالة الانغماس والاندماج مع الذات الجديدة.
ومع هذا تكشف السيرة في أحد جوانبها عن توتر نظرة سعيد للآخر- أميركا، بوصفه مواطنا عربيا تارة، ومواطنا أميركيا تارة ثانية، وهذه النظرة تتصل برؤيته للاستشراق كما في كتابه المهم. فسعيد طيلة تواجده في أميركا، كان في رحلة بحث عن هذا الآخر المندمج معه بحكم الهوية وبحكم الثقافة وبحكم اللغة التي صارت هي المهيمنة على كتاباته، فعلاقة عدم الاستقرار التي وسمت مرحلته الأولى أثناء الدراسة، كانت تعكس صورة النظرة العدائية ضده، بوصفه مواطنا من الشرق، وقد تجلى هذا في عدم حصوله على ترقيات داخل المدرسة وكذلك تخطيه في تمثيل المدرسة في أدوار مهمة، كأنْ يلقي كلمة الخريجين وهو الحاصل على تقديرات تؤهله لهذا. أيضا عبر علاقته بأصدقائه الذين درسوا معه في المدرسة أو من التحقوا معه بجامعة برنستن.
ثم جاءت مرحلة المناضل في دفاعه عن القضية الفلسطينية من إحساسه مع امتلاكه الجنسية الأميركية، وأن ذاته هي ذاتهم، إلا أن ثمة إبعادا أخرى وفوقية، ونظرة دونية، جعلته أكثر إصرارا على الدفاع عن القضية.
لم يكتب تمثي برنن سيرة غيرية لإدوارد سعيد، بل على العكس تماما كتب سيرة أشبه بالذاتية، معتمدا على الوثائق التي خصته بها أسرة سعيد، إضافة إلى شهادات المقربين منه، وما يقرب السيرة الجديدة من السيرة الذاتية لا الغيرية (حسب ظني الذي قد يخالفني فيه الكثيرون) أن تمثي برنن لم يكن خارجا عن السيرة أي مجرد راوٍ أو منظم للوقائع، وإنما كان محللا لشخصية إدوارد من جانب ومن جانب ثان قدم قراءة موزاية لأفكار سعيد ومشاريعه الفكرية، لكنها ليست قراءة منفصلة، وإنما قراءة مرتبة ومنظمة في ظل سياقات إنتاجها وما لازمها في صخب وجدل معرفيين، ولأول مرة نكتشف أن كتاب الاستشراق أولا كان استجابة للحرب العربية الإسرائيلية عام 1973ـ كما أنه كان مشروعا ثنائيا بينه وبين تشومسكي لأنه انتهى الحال ليكتبه سعيد وحده.
برنن وهو يستعيد سيرة إدوارد سعيد يتبع منهجا مختلفا في كتابة السيرة الغيرية أو الذاتية، فهو لا يتوقف فقط عند المعلومات الشخصية، ومصادرها الأساسية التي تكون في الغالب من الأقارب من الدرجة الأولى، أو حتى الأصدقاء (يضع قائمة بأسماء من قابلهم وتاريخ المقابلة ومكانها في نهاية الكتاب)، وإنما يلجأ إلى نصوص سعيد النقدية وكتاباته المختلفة، فنراه دائم المراوحة بين ما يقال عن سعيد وما رواه سعيد بنفسه في خارج المكان، وما عبر عنه نقديا في كتاباته (النقدية والفكرية والذاتية)، كما يلجأ إلى تحليل هذه المعلومات بمقاربتها بمصادر أخرى تتمثل في كتابات ومرويات أدبية مختلفة، فتترد أفكار ألبرت حوراني وصادق جلال العظمة وشارل مالك، وعبدالله العروي، ومقدمة ابن خلدون، وشتراوس ولوسيان جولد مان، وفوكو،وتشومسكي وغيرهم.
كما يلجأ إلى الأعمال الروائية، فمثلا في حديثه عن الطابع الذي تميزت به القاهرة باعتبارها مدينة حديثة، كان لها بالغ التأثير في تكوين سعيد الفكري، يلجأ إلى روايتي “بين القصرين” و”زقاق المدق” لنجيب محفوظ، للتأكيد على حداثة المدينة وما تتمتع به من طابع علماني، حيث “الخليط المربك من الأقليات الدينية” وما يعكسه من تقسيم جذري للقضاء القاهري، بل لا يكتفي بما هو تمثيل ظاهر في مرويتي محفوظ، فيذهب إلى التدليل من سيرة محفوظ نفسه، ورواياته، فيقول “فإنه صور بصدق مسارا جسده هو نفسه، فتنقل في رواياته (وفي حياته) بين القسم المزدحم المأهول بالطبقة العاملة المسلمة من مدينة الجمالية، القديمة إلى ضاحية العباسية الداخلية ذات الطراز الأوروبي”. وإن كان يعود سعيد لنجيب محفوظ ويقارنه بالجيل الأحدث، الذي يعتبره الأفضل، في رأي مخالف لكتاباته الرسمية.
فالسارد وهو يصوغ السيرة من منظور غيري، لا يأخذ كلام سعيد وكأنه مسلم به، بل يعمد إلى مطابقته بالواقع، فمثلا عندما يتحدث سعيد عن مدرسة “ماونت هيرمن” التي ألحقه بها أبوه كي تعيد له الانضباط الديني، يصفها سعيد بأنها “تكتم الأنفاس”، ولكن تمثي يعقب بناء على مشاهدة أو معاينة للمدرسة بأن “الأدلة المتوفرة لا تؤيد ذلك الوصف”، يتكرر هذا عندما يسرد إدوارد أنه طرد من كلية فكتوريا، فيصحح ثمتي المعلومة ويقول “إن الأمر ليس صحيحا من الناحية الإجرائية، وإنما هو فصل لمدة أسبوعين بسبب مجادلة مع معلم”.
وأحيانا تبدو السيرة أشبه بمراجعة لأقوال سعيد، وانتقادات التلميذ لأستاذه في بعض مواقفه، ومن هذا موقفه من مؤتمر باندونج الذي تجاهله سعيد في مقالته عن عبد الناصر وأزمة السويس. وأحيانا يأخذ السارد دور المفسر لما كتبه في مذكراته (خارج المكان)، فيبرر مثلا سخريته من شارل مالك أحد المؤثرين الفكريين في تكوين وعي سعيد. ونراه يستنكر من تصريح سعيد بما صرح به في مذكراته عن علاقته بهايدجر، وقال من الممكن قبول ما ذكره عن كونراد وفوكو، فالاستشهادات في كل مكان في كتاباته، “لكن هايدجر لا يذكر إلا عابرا”.
السيرة النقدية
السيرة في أحد جوانبها هي بحث عن الروافد التي شكلت الوعي والفكر النقدييْن لسعيد، فالاستشراق الذي عمل عليه هو من تأثير شارل مالك أحد أهم الشخصيات الأربع تأثيرا في وعي سعيد، وتحديدا مقالته عن “الشرق الأدنى”، والتي رسم فيها حدود المعرفة الأساسية التي ينبغي استقصاؤها إن أريد فهم ثقافي لظاهرة المستشرق، وفيها حدد مالك مقدار الخير الذي سببه الاستشراق، كما أن المنهج الدنيوي الذي كان نتاجا لكتاباته الأولى البدايات والنص والعالم والناقد، هو من تأثير الناقد بلاكمر، خاصة ما استمده من الرؤية الدينية عند هوبكنز لجعل النقد رسالة دنيوية.
أما المفردة نفسها فهي من كتاب أورباخ “دانتي شاعر العالم الدنيوي”، ومصطلح البيان الذي استخدمه في أعقاب الانتفاضة الأولى، ودعا إلى مؤتمر دولي تحت عنوان بيان، هو مستعار من مقدمة ابن خلدون، والذي يعني عنده “القدرة على استخدام المفردات للتعبير عن الأفكار التي يرغب المرء في التعبير عنها…”
الشيء المهم الذي ركز عليه برنن هو أنه رد الأفكار التي طرحها إدوارد سعيد في كتاباته المختلفة إلى مظانها الرئيسية، ولم يكتف بهذا، بل قدم ما يشبه الصياغات الأولى للأطروحات التي شكلت أساس كتب إدوارد سعيد، وموقف المتلقين من أصدقائه وأساتذته من هذه الأطروحات، ومحاولات سعيد لإعادة الصياغة والتجريب حتى اهتدى إلى الصوت الذي يريده، وسط حالة من الجدل والصراعات بين الأفكار المتضادة، فهو يفضل كونراد السوداوي مع أنه يعشق أشعار بليك المعادي للاستعمار وصاحب الأشعار الرؤيوية، وكذلك كان قلبه ميالا لسارتر إلا أنه أحب دروس ميشيل فوكو المناهض لسارتر، ويدعو التلاميذ لقراءة دولوز رغم أن أهداف دولوز كانت تتعارض مع آرائه، وكأن السيرة كشف لديالكتيك سعيد نفسه.
قوة تأثير الأفكار التي صاغها أساتذته كان لها دور كبير في تشكيل وعيه، على الرغم من اختلافات سعيد مع بعض أفكارهم على نحو اختلافه مع أفكار شارل مالك الدينية المتشددة، لكن يبقى تأثير هؤلاء واضحا عليه فكريا وعلى مسيرته النقدية، وهو درس من دروس سعيد، فسعيد نِتاج أفكار متعددة الثقافات أيضا، بدءا من أيديولوجيا أمه المنحازة إلى القومية العربية، وعمل عمته الخيري الذي أسهم في شدة إيمانه بالقضية الفلسطينية ودفاعه عنها، فقد كان مصدره للأعمال الخيرية، تردده مع عمته على الجمعيات التي تشرف عليها. وبالمثل بلاكمر هو الذي علمه وأثر فيه بقوله “تقريب الأدب إلى الأداء” وهو الشكل الذي لجأ إليه سعيد للاستفادة من المهنة التي تخلى عنها، وهي مهنة عازف البيانو، فصار الناقد موسيقيا يؤدي دوره أمام المستمعين، وبأن يتخيله خطيبا يدافع عن قضية في محكمة.
كشفت السيرة عن عقلية إدوارد سعيد القلقة، ومطاردته للأفكار، من خلال مشروعيْن الأول؛ مشروعه عن كونراد وهو رسالة الدكتوراه، ثم مشروعه عن سوفت، وهو الذي لم يتم، وإن كان قطع شوطا بعيدا في دراسته، والسبب هو حالة القلق وعدم الرضا عن النتائج. وقد يتضح بصورة أخرى في إعادة تقييمه للإله الخفي لجولد مان في ضوء تصور جديد بعد قراءته ” فرانز بوركناو” أحد أعضاء مدرسة فرانكفورت.
يدخل المؤلف برنن مع سعيد في نقاش فكري مباشر وغير مباشر، إذ يقارعه الحجة بالحجة في الكثير من الأفكار التي طرحها في كتاباته المختلفة، وهو يستعرض لكتابات سعيد، وكما سبق وأن ذكرت عاليا، بأنه يرد النصوص إلى مظانها (الأصول الأولى) التي استقى منها سعيد لبنات أفكاره، وأحيانا يعيد قراءة كتب إدوارد في ضوء كتب مماثلة لها في الفكر والرؤية، وربما كانت أسبق منها، على نحو ما عرض من قراءات موازية لكتاب الاستشراق، بأنْ استعرض جملة من الكتابات التي لعبت على ذات التيمة التي جعلها سعيد محورا لكتابه، كما في كتاب فيليب حتي “الإسلام والغرب” (1962)، وميخائيل رستم صاحب كتابي “الغريب في الغرب” (1895) الذي يفكك الأكاذيب الغربية وتمثلاتها عن الشرق كما في كتابي هنري جسب “الحياة البيتية السورية” (1874)، و”نساء العرب” (1873)، ثم التمثلات بين كتاب الاستشراق وما جاء عند عبدالله العروي “أزمة المثقفين العرب” (1973).
ومن جهة ثانية كان يضع كتابات سعيد في مواجهة مع الكتابات التي تنتقدها، وأبرز مثال لذلك إبرازه لمقالة جلال العظمة عن كتاب الاستشراق والمآخذ التي أخذها على كتابه، وعبر هذه النقاشات التي كانت تصل إلى جدال وخصام، كان يسعى إلى أن يعكس – لا أدري بقصد أو دونه – الجانب العدائي عند سعيد في ردوده، والتي تبدو في صورة مغلفة بالسخرية، وإن كانتْ كتبتْ بلهجة لاذعة شديدة الحدة، بل كان تمثي ذكيا لانتقاد أستاذه بأن أظهر التباينات في تلقي كتاب سعيد، والتي وصلت إلى الهجوم على سعيد والتقليل من منجزه.
في الأخير إذا كان إدوارد سعيد وخاصة كتابه الاستشراق المؤسس لدراسات ما بعد الاستعمار، قد ساهم في انتشار مصطلحات مثل الآخر والهجنة والاختلاف والهوية، والمركزية الأوربية إلخ.. فإن سعيد نفسه نستيطع أن نقول عبر هذه السيرة الغيرية، كان التمثيل الحقيقي لمثل هذه الأطروحات، فاستطاع بأناه الأحادية المضطربة والمطاردة بالمنفى، تفكيك المركزية الأوروبية، وكشف البنيات المضمرة للآخر المختلِف الهوية والهجنة، في تأكيد لمقولة “التابع ينهض”، ومع ما حققته هذه الأنا من حالة الانصهار والاندماج مع الآخر، إلا أنه لم ينس البدايات، فمع معرفته بإصابته باللوكيميا (يونيو 1992)، إلى جانب شعوره بالعزلة السياسية، بدأ يفكر في “العودة إلى البدايات“.
وبقي أن أشير إلى أنني التزمت في كتابة أسماء الأعلام الأجنبية بالصورة المتعارف عليها، ولم أكتبها كما انتهجها مترجم الكتاب داخل المتن، كأن يصير إدوارد إِدْورْد، وتشومسكي “جومسكي”، وفريدريك جيمسون فردرك جيمسن، وتشارلز ديكنز جارلز دكنز، وت. س. إليوت يصير ت. س. إليت، وجائزة البكر بدلا من جائزة البوكر إلخ…. هذا للتوضيح، وإن كان المترجم أبدى أسباب انتهاج هذا الشكل الكتابي في المقدمة.
كاتب مصري
العرب
——————————————-
أن يكون المرء مشرقيا معناه أن يعيش في عالمين/ أسامة فاروق
في كتابه “إدوارد سعيد أماكن الفكر”، يتتبع تيموثي برينان بدقة المسار الفكري الذي انتهجه سعيد طوال حياته، ليقدم صورة غير مسبوقة لأحد أعظم العقول في القرن العشرين. لذا كان طبيعياً أن تتعدّد خيوط الكتاب وتتشعب وفقاً لحياة صاحبها الذي كان “رائداً لدراسات ما بعد الاستعمار، وناقداً أدبياً واسع الثقافة… مفكراً من مفكري نيويورك، ويعمل في ترتيب الحفلات الموسيقية في فايمار، ويبرع في سرد الحكايات على شاشة التلفزيون القومية، ويفاوض من أجل فلسطين، ويمثل في أفلام يؤدي فيها دوره في حياته..”. من بين كل تلك الخيوط المتشابكة كانت مؤلفات سعيد وحياته الجامعية بالطبع، الخيط الأبرز الذي تتبعه المؤلف بوصفه تلميذه، حيث قدم دراسة شديدة التعمق في مؤلفات سعيد، وما أضافته للحياة الأكاديمية، كواليسها وما دار حولها في صفوف الحياة الفكرية وامتداد تأثيرها حتى الآن، خصوصاً أن كتاباته “غيرت وجه الحياة الجامعية إلى الأبد”.
ورغم ذلك كان خط التأليف الروائي هو الأكثر لفتاً للأنظار منذ صدور الكتاب في نسخته الإنكليزية قبل عامين، ربما لأنه كشف جانباً مجهولاً من حياة سعيد الغنية والحافلة على الصعيد العلمي والسياسي، خصوصاً أن التحليل الذي يقدمه المؤلف للأجزاء التي اطلع عليها من تلك الأعمال يكشف الكثير عن شخصية سعيد نفسها، وتطور رؤيته للإبداع الروائي ودوره، بل حتى رؤاه السياسية. فقد كان “الأدب في فكره ليس مجرد مهنة يحبها، بل هو الأساس الذي تقوم عليه أفكاره السياسية، والسر الكامن وراء حب الناس له”. حتى تراجعه عن استكمال ونشر تلك الأعمال، وجد من يفسره في خدمة الفكرة نفسها، معتبراً أنه في ظل غياب رواية من وضعه فإن “الإبداع القصصي الحقيقي هو حياة سعيد نفسها”.
مرثاة.. سيرة معدلة
يؤكد برينان أن لسعيد محاولات عديدة للكتابة الأدبية والروائية تحديداً، لكنها لم تكتمل. كانت أشدها طموحاً تلك التي بدأها في بيروت العام 1962 واختار لها “مرثاة” كعنوان مؤقت، وكتب منها 70 صفحة بالفعل، علاوة على 13 صفحة من الملاحظات قال في إحداها إنه تمكن أخيراً من وضع مخطط للرواية “ثلاثية؛ 3 قصص تشكل كياناً واحداً.. تجارب من انعدام اللافشل!”.
كانت قصته كما يصفها برينان، وكما يحصل مع أغلب من يكتبون روايتهم الأولى، تصويراً شبه مخفي لعناصر من طفولته، و”محاولة لبعث الحياة في القاهرة في الأربعينيات” المدينة التي رسا فيها مركب طفولته بينما كانت القدس المدينة التي ولد وعمد فيها وحصل فيها على تعليمه المدرسي المبكر، حيث كانت الحياة اليومية في الشرق الأوسط في سنوات طفولة سعيد مملوءة بالتنقل لأكثر السكان، وهو ما عزز مفهومه لفكرة الوطن بعد ذلك، كما “ساعد وجوده غير المستقر في بواكير حياته على تفسير ولاءاته الثقافية المتغيرة”. فخلال سنوات قليلة، انتقل سعيد من كلية القديس جورج في القدس، إلى مدرسة الجزيرة العامة، ومنها إلى مدرسة القاهرة للأطفال الأميركيين (1948-1949)، انتهاء بكلية فكتوريا التي التحق بها ما بين العامين 1949-1951. لذا كانت شخصيات روايته الأولى مغزولة من طبقات المدينة وقومياتها وأديانها، كلها تغطي في المجمل شريحة طموحة من مجتمع القاهرة، التي يصفها المؤلف بأنها كانت أكثر العواصم العربية استعداداً لاستقبال الناس بعد بيروت. وفي الوقت الذي قضاه سعيد فيها كانت لاتزال عاصمة ساحرة غير مزدحمة نسبياً ذات طبيعة علمانية عالمية، تنتظرها تغييرات سياسية جذرية “كان سعيد محظوظاً من حيث التوقيت”، كما يقول. علاوة على المكان أضاف سعيد كذلك شخصيات من عائلته وأصدقائه: “نجد بين الشخصيات صيغة مشوهة من أبيه باسم حليم خوري، وهو مسيحي لبناني ولد في المدينة، ويملك “شركة فاشلة للطباعة، ودكاناً قذراً للقرطاسية” و”تورط في صفقات تجارية مشبوهة” ومن المعروف أن تجارة الأب في الواقع كانت هي المزود الرئيس لمعدات المكاتب للجيش البريطاني المحتل ولحكومة الانتداب المصرية، وكانت علاقه سعيد بوالده متوترة على الدوام، على نحو ما وصفه بعد ذلك في مذكراته.
يصف برينان الأجزاء التي اطلع عليها من مخطوط الرواية، فيقول إن نثر سعيد كان يتوافق تماماً مع متطلبات المشهد، وأنه لو توافر الوقت ولم يكن لديه شيء آخر يفعله لأكمل المشروع وأوصله إلى مرحلة النشر، فالكتابة لديه “سيالة، واثقة، مكتملة. والشخصيات التي يوجد بعضها في القاهرة وبعضها الآخر في هليوبولس تمضي قدماً بترتيب يثير الإعجاب”. شخصيات من أيام مدرسة القديس جورج في القدس، وأخرى تقترب في تفاصيلها من معلمه الموسيقي تيغرمان صاحب التأثير الأكبر في تذوقه للموسيقى، إضافة إلى صور معدلة من سيرته نفسها.. “أما مفيد فهو شخصية يسخر سعيد بواسطتها من نفسه فتستمد مادتها من السنة التي قضاها في شركة القرطاسية”.
يعلق المؤلف أخيراً بأنه سعيد، وهو على أعتاب أن يصبح أستاذاً جامعياً، كان يفكر في أن القصص قد تكون منصّة يعبّر بواسطتها عن كل تلك الصراعات الداخلية التي كان عمله البحثي يمر عليها مرور الكرام.
لن يكمل سعيد روايته لتظل “مرثاة” غير مكتملة إلى الأبد، وإن كتب بعدها قصة قصيرة بعنوان “سفينة لمن يصغي”، أرسلها إلى “النيويوركر” في 26 فبراير 1965، واستقى مادتها من ذكرياته في ليالي الصيف في ضهور الشوير، وفيها يروي قصة آل أندراوس الذين لجأوا إلى البيت الصيفي لصديق لبناني بعدما أُجبروا على الخروج من فلسطين. ويصفها برينان بأنها أفضل ما أنتجه سعيد من نثر إبداعي. وربما كان رفضها من قبل المجلة سبباً في توقفه عن كتابة القصص لمدة تجاوزت الـ20 عاما!
عودة لأرض الرواية
وما بين العامين 1987 و1992 عاد سعيد إلى أرض الرواية مجدداً، وعمل على نحو متقطع على رواية حول الخيانة، تداخل بعدها مع موضوع آخر عن عجز الرجال من العرب قبل أن يتخلى عن المشروع تماماً. كانت الخلفية المختارة للرواية، وفق الكتاب، هي بيروت أيضاً، لكن عشية الأزمة السياسية التي نشبت في العام 1958: “كانت الحبكة ستتناول التجسس، وظلم الشرطة، والإذلال الذي تسببه السياسة بصفتها عناصر الحبكة الكبرى”. لكنه في النهاية لم يكمل منها إلا 45 صفحة، ومن بينها ملاحظات تفصيلية وملخصات لصفحات لم يكتبها. تدور الرواية حول اختطاف طالب طب شارك في الاحتجاجات الطلابية ضد آيزنهاور، ويخونه مخبر، ويؤخذ إلى سجن سري. وتظهر فيها أيضاً شخصيات عرفها سعيد في حياته “أما سعيد نفسه فهو مزيج غامض مشوَّه من شخصيتين مختلفتين، أسعد فرانكوب وهو شخصية حرباوية يثرثر كثيراً، ويقيم علاقة غرام مع صحافية مرتبطة بجاسوس أميركي سري، وصدقي، وهو رجل في الخمسين يحمل شهادة دكتوراه متميزة في الفلسفة، وتثير كتبه المنشورة الكثيرة وسمعته الدولية زملاءه في بيروت لأن يذلوه بأن يطلبوا منه الحصول على شهادة الثانوية العامة المحلية قبل السماح له بالتدريس في الجامعة”. على نحو ما واجهه هو نفسه من تجاهل عندما عرض تدريس إحدى المواد من دون أجر في الجامعة الأميركية ببيروت، ووصل الأمر إلى حد وضع عراقيل أمام حصوله على شيء من البساطة، ما يبلغه الحصول على بطاقة تخوله استعارة الكتب من المكتبة! على حد وصف المؤلف.
لكن الأهم هو التحليل الذي يقدمه برينان لهذه الصفحات المتناثرة، التي اعتبرها فرصة لا تقدر بثمن للاطلاع على مقاصد سعيد الجمالية، فضلاً عن لمحة السخرية من الذات التي تظهر هنا وهناك. ووفقاً لتحليله، فإن بيروت مثلاً لا يمكن أن تمثل إلا نفسها في الرواية، “المكان الحرفي الذي يجمع المتعة ذات الصبغة العالمية والكفاح والمهانة اليومية”، لكنها تمثل أيضاً “مسرحاً عربياً في طور الظهور”. أما فرانكوب فليس شخصاً بقدر ما هو نمط إشكالي، “الرجل المتحرر تماماً” الذي “يمكنه التخلص من أي شيء من دون أن يراكم تاريخاً”. أما صدقي، وهو أكثر الشخصيات رمزية، فيمثل المثقف الغربي الذي “انقطع عن العرب والغرب، وهو على وعي باليهود… عاجز عن التغير، وأصدق من أن ينتمي”.
ترك سعيد الشكل النهائي للرواية غير واضح، لكن برينان استمر في تحليل التعليمات التي وضعها لنفسه، منها مثلاً تأكيده على فكرة تحطيم “المسار السردي الطويل” المرتبط بالرواية الواقعية التي كان من رأيه أنها مسؤولة عن خلق أوهام الاستمرار: “فقد شعر أن ذلك لا ينطبق على التجربة الفلسطينية”. ومن نصائحه أيضاً: “التزم بما هو غير كامل”، “أنا أثق بقصرها المشتت، بأنها تسعى دائماً إلى البدء من جديد”، معتبرا أنها الطريقة الوحيدة التي تمكنه من تجاوز “الانضباط المؤذي… وتسمح لذاتيتي بالتدفق”. ويعلق برينان: “أراد أن يتحاشى، مهما كان الثمن، الشكل الاعترافي الذي يطبع كثيراً من ذلك الشعر الغنائي وذلك الفن الروائي التسجيلي السيء الذي ينتجه العالم الثالث”. كان سعيد في هذا التوقيت يراجع قناعاته بالنسبة للفن الروائي العربي بالتحديد، أو ربما شعر بالفزع من شخصية المؤلف كما يقول برينان، وكان لهذا الفزع دور كبير في تخليه عن الرواية، مشيراً إلى تأكيد سعيد لهذه الفكرة في مقالة ألهمته كتابتها صديقتُه، نادين غورديمر، الروائية الفائزة بنوبل، وفيها تحدث عن المؤلفين بوصفهم “كوميديين اجتماعيين تنتهى وظيفتهم عندما يمسكون بالوجود بالكلمات من دون رهبة أو على نحو جميل”. وهي الرؤية التي يعلق عليها برينان بقوله “إن الروائي لا يكتمل إلا بالنقد، وهذا يعني قول لا لما هو موجود، وليس إعادة إنتاجه”. وهو ما يتطابق مع قاله أستاذه سعيد نفسه، سابقاً، بلهجة تأكيدية “أنا لست فناناً”، معتبراً أن قصارى ما يطمح إليه الناقد هو أن يكتب ليُفهم “وهذا فيه من الفن ما يكفي”.
لذلك يقول برينان أنه عندما بدأ سعيد في العام 1992 بكتابة مذكراته “خارج المكان”، فإنه فعل ذلك ليس لأنه فشل في إتمام الرواية، بل لأنه رفض إتمامها “ففي انقلاب على النفس في الجزء الأخير من حياته في ضوء حياة قضاها في التعليم، رفض الرواية بوصفها شكلاً من أشكال الأدب، وقال إنها لم تعد تعني شيئاً”.
خارج المكان
لكن ذلك لم يكن العامل الوحيد، ففي سبتمبر 1991 وقبل أن يزيح الرواية جانباً، أظهرت الفحوص الطبية التي أجراها أنه يعاني من لوكيميا تضخم الأنسجة اللمفاوية المزمن، وبعد سنوات من المعاناة ومع نهاية عقد التسعينيات كان العلاج الكيميائي قد دمر حيويته “شحب وجهه الجميل وغارت وجنتاه. وجعله ورم في البطن يبدو كأنه يضعف ويزداد وزنه في الوقت نفسه”، لذا فإنه يقول إن سعيد بدأ كتابة “خارج المكان” في مايو 1992 كـ”رد مباشر على التشخيص الذي يهدد بالنهاية”.
لكن الواضح أنه لم يتخل عن حلمه بالكامل، بل أراد إقناع نفسه بأنه حققه بشكل ما، فبعد النجاح الكبير الذي ناله “خارج المكان” أخذ يصفه باستمرار بأنه “رواية توثيقية”. وفي مقابلة مع مجلة “تايم” أجراها أثناء كتابته، قال إنه يكتب “شيئاً أشبه بالرواية”، وإن لم يعن هذا التوصيف برينان كثيراً. إذ اعتبر أن الكتاب في المجمل، بغض النظر عن التوصيف، يعد تتويجاً لمسيرة سعيد، وأنه صار أكثر من غيره “الكتاب الذي جمع مواهبه كلها في مكان واحد”، حيث رأى أن كل كتاب من كتبه ترك أثراً، وعُدّت ثلاثة منها على الأقل أحداثاً مهمة. لكن المديح الذي ناله “خارج المكان” كان شاملاً، فإلى جانب المراجعات الحماسية والجائزة التي منحتها إياه مجلة “النيويوركر”، فقد انهالت عليه رسائل الإعجاب من كل مكان، وبعضها كان من كتاب حائزين جائزة نوبل وحتى بعض نجوم السينما.
بحسب برينان، فإن سعيد كان ينوي أن يسمي كتابه “ليس صحيحاً تماماً”، وتمسك بهذا العنوان حتى قبل الدفع به للمطبعة بوقت قصير، لكنه فكر في النهاية أن موضوع المنفى الملتصق بكلمة “المكان” سيكون أوضح وأقل غموضاً من العنوان المتروك، وهو أيضاً العنوان الذى أوحى بالروح الداخلية للكتاب، وهى كما يقول ليست عن المنفى بل عن عدم العيش في المكان الصحيح، عن عدم الشعور بأنه “في بيته” في أي مكان. وهو ما تحقق فعلاً على نحو ما خلال حياته، وحتى قبل رحيله بوقت قصير، فقبل رحيله بشهر تقريباً، بالتحديد في أغسطس 2003، رفض المسؤولون في شركة طيران البرتغال أن يسمحوا له بالصعود للطائرة في رحلة العودة لأن اسمه تسبب في استثارة تحذير في جهاز ما. فتح رجال الأمن حقائبه فتناثرت كتبه وأدويته حوله، وشعر بأنه أُهين على نحو بالغ، وقال بصوت غاضب وضعيف: “أنا ولدت مواطناً أميركياً، وعشت في الولايات المتحدة من خمسة وأربعين سنة إلى خمسين”. ويعلق برينان تعليقاً لافتاً على الموقف كله فيقول: “سواء أخرته شركة الطيران على باب الطائرة بسبب إجراء عادي نتيجة للتصنيفات الإثنية المعتادة، أو استهدفته بسبب أنشطته السياسية بناء على أوامر من دائرة الهجرة في الولايات المتحدة، فإن النتيجة تبقى كما هي. كان يعد غريباً في صباه في القاهرة لأنه أميركي، أما بلده الأميركي فلم يعدّه أصيلاً فيه”. نتيجة كان قد توصل إليها سعيد بالفعل في شبابه، حيث يكشف كتاب برينان عن قصاصة تنتمي إلى المرحلة الجامعية، تسجل أولى محاولات سعيد لتعريف الذات يقول فيها: “أن يكون المرء مشرقياً معناه أن يعيش في عالمين أو أكثر من دون الانتماء إلى أي منهما”.
(*) صدرت النسخة العربية من كتاب “إدوارد سعيد أماكن الفكر” لتيموثي برينان، مدرس العلوم الإنسانية بجامعة منيسوتا في الولايات المتحدة، ضمن سلسلة “عالم المعرفة” الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، بترجمة محمد عصفور.
المدن