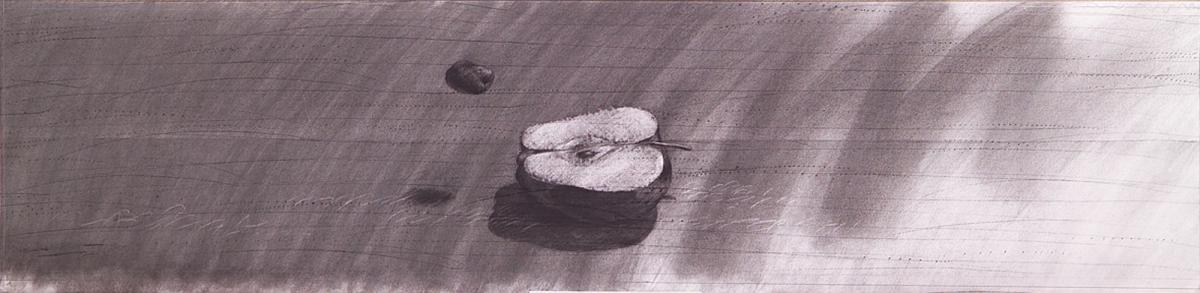عقد من القرن الجديد في ثقافتنا

يوسف عبدلكي
يبدو أن الوضع التشكيلي العربي اليوم يمر بحالة حراك غير مألوفة، يتجلى هذا على مستوى المفاهيم، وعلى مستوى أدوات التعبير ، (حراك ) وليس أزمة كما يحلو للكثيرين الترديد بمناسبة أو بدونهاوليس بقليل الدلالة ما نراه اليوم في البيناليات العربية حيث تتراجع سطوة اللوحة، وتحل مكانها أعمال فنية جديدة تقطع مع تاريخ اللوحة العربية، وترتبط بمفاهيم معولمة عن التشكيل ودلالاته ودوره .
مر الفن التشكيلي في البلاد العربية منذ بداية القرن العشرين (وبتواريخ مختلفة في كل بلد) بعقود كان فيها امتلاك ناصية التقنية الغربية هي الهاجس الأول، وسعى الفنانون خلال ذلك إلى القبض على لوحة الحامل بموضوعاتها المعروفة: البورتريه، المنظر الخارجي، الطبيعة الصامتة … الخ (أحمد صبري، توفيق طارق، فروخ…) حيث أن فنون بلادهم ما قبل الرأسمالية لم تعد تستجيب لأشواقهم في ظل اكتساح التقدم الأوروبي للمجتمعات القديمة وأنماط عيشها وثقافتها، وحيث التماهي مع الآخر القوي سنّة في تواريخ البلدان .
في منتصف القرن تحولت الأفكار الجنينية التي وجدناها تريد الإمساك بالتقنية الغربية وإعلان الانتماء إلى ثقافتنا المحلية في آن معاً (راغب عياد، مختار، عبد القادر الرسام …)، تحولت تلك الأفكار إلى نغمة واسعة خاصة مع الاستقلالات، وأحلام التنمية المستقلة، وصعود الأفكار اليسارية، وانتصار حركة الضباط الأحرار، والبعثين السوري والعراقي في السياسة العربية.. هكذا انغمس التشكيل في بحث عن الهوية، وأصبحت من البديهيات الصلة مع الإرث البصري العربي الإسلامي وما قبلهما (فرعوني، آشوري، بيزنطي، رسوم حائط، زخارف، خط … الخ). المحور العريض الآخر كان الصراع الذي احتدم بين أنصار الواقعية وأنصار التجريد (الفن للشعب ـ الفن للفن)، وكما بات معروفاً لم يكن ذلك إلا انعكاساً للحرب الباردة إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، وانقسام العالم إلى معسكرين، وبغض النظر عن درجة وعي الفنانين أنفسهم بذلك أو اعتقادهم بشخصياتهم وفردانيتهم واستقلالهم .
في العقود الماضية استمرت هذه المفاتيح في صياغة التوجهات العريضة في فنوننا التشكيلية بأشكال ورؤى متباينة بقدر تباين الفنانين أنفسهم وتعددهم وسويات مواهبهم، غير أننا نشهد منذ سنوات عديدة دبيباً لا ينفك يتصاعد مع مرور الوقت، وهو استقدام تقنيات وأساليب أداء تشكيلية جديدة أبرز ما فيها القطيعة مع لوحة الحامل ومع قضايا التشكيل السابقة وتقنياته المعروفة، وهكذا لم نعد نرى في فنون الفيديو والفنون التركيبية (Installation) أي صدى للواقعية أو التجريد أو الإرث البصري للمنطقة أو للنهل من الفنون الشعبية … الخ. إنها أدوات عريضة يمكن الذهاب بها شتى المذاهب – كأي تيار أو مدرسة – وفق تصورات الفنانين وأصالة مواهبهم. وكأي تيار فيه الغث والسمين وفيه الواقعي والشاعري والسريالي والاجتماعي … الخ وعموماً إنها أعمال تريد أن تقول، أي أنها في جوهرها تقطع مع تعالي التجريد عن المعنى. ويلحظ فيها ـ حتى خارج النطاق العربي – اتساع المسافة بين أفكار الفنانين وقدرة أعمالهم على التوصيل حيث الكثير منها يبقى أعمالاً لغزيّة للمشاهد، بينما تكون خارطة العناصر والدلالات واضحة في ذهن الفنان .
أصبحنا إذاً أمام مشهد تشكيلي جديد، قد يبدو للبعض هامشياً، وهو كذلك في نطاق صالات العرض الخاصة (لصعوبة تسويقها)، غير أن هذا المشهد راح يتلقى دعمين مؤكدين :
الأول من البيناليات العربية .
رأينا منذ أعوام استقدام مفوض إنكليزي لبينالي في بلد عربي، فنحىّ تماماً اللوحة بكل تعسف! واقتصرت العروض على الأعمال التركيبية والفيديو وفنون الأرض.. الخ) حيث يضخ المسؤولون الجوائز لأصحاب تلك الأعمال في رغبة مفتعلة لجعلها نغمة سائدة، أو ربما للقول للآخر الأوروبي بكل عقد النقص والتخلف المشهود:
نحن أيضاً «معاصرون» مثلكم.
الدعم الثاني يأتي مباشرة من مؤسسات غربيّة لا تدعم ولا تشجع غير هذه الأعمال، وربما تكون مصر هي أكثر البلدان العربية التي تلحظ فيها هذه الظاهرة. ويذكر ذلك بمسألة أسالت الكثير من الحبر في الأعوام الأخيرة، وربما لا نجافي الصواب عند القول بأنه مثلما أساء التمويل الخارجي لقضايا في منتهى الأهمية والجدارة مثل حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ها هو التمويل الخارجي نفسه ينخر في إمكانية التطور الطبيعي لفنوننا البصرية، حيث ينساق معه عدد من الفنانين الشباب شديدي الحماس، قليلي الخبرة، كثيري الحاجة .
أعتقد أنه لابد من تثبيت أن هذه الفنون «مشروعة» تماماً، ولها حق الحياة بالضبط مثل باقي الاتجاهات والتيارات طالما أن هناك فنانين عربا يؤمنون بها ويرونها أداتهم في التعبير. المأخذ على هذه الفنون هو ضعف صلتها بمجتمعاتها، وكما كان المأخذ في منتصف القرن الفائت على الفنانين العرب (وغير العرب) المتماهين مع الفنون الغربية دون كبير التفات لا لمحيطهم ولا ـ ربما – لذائقتهم العميقة الشخصية، فإن هذا المأخذ يمكن توجيهه بنفس الحدة النقدية إلى هذه الفنون .
على المقلب الآخر، مقلب السوق، نجد صورة متباينة، تسود فيها لوحة الحامل ( وتكاد تختفي بالكامل الأعمال التركيبية وأعمال الفيديو )، ويتم العمل فيها على محورين :
تكريس الفنانين الأوائل أو الرواد أو الراحلين،
وحقن السوق بأعمال فنانين جدد من سويات مختلفة، فيهم ذوو الموهبة المؤكدة، وفيهم متوسطو السوية، وفيهم الأقل والأقل.
يتم ذلك الحقن بوسائل العرض المألوفة أو بقوة الانتشار الإعلامي أو الدعائي المباشر، وليست موجة المزادات العلنية للفن العربي منذ عدة أعوام إلاّ إعلانا ساطعا على سطوة السوق على فنوننا وفنانينا . وتتولى المؤسسات الغربية دعم هذه الظاهرة .
هنا لابد أن نلحظ أن السوق غير معني برؤى أو أساليب أو تقنيات.. لا يهم السوق سوى الربح، لذا يتساوى في سلّته الفنان الواقعي والفنان المجرد، المسيس والحروفي، الشعبي أو الأوروبي النزعة… الخ، كله حسن طالما أنه يباع .
تحويل فنوننا البصرية من أداة للتعبير عن هم وجودي يسعى فيه الفنان إلى بث رؤيته، قلقه، فرحه، تناقضاته، نزعاته العميقة وسلم جماليته، تحويل كل ذلك إلى سلعة هو أمر لابد من الوقوف عنده، والخوف الجدي منه .
نحن اليوم أمام خارطة جديدة لم يعرفها الفن العربي طوال عقود كاملة، خارطة يحل فيها التماهي مع الغرب محل الغرف من المنهل المحلي والتاريخي للمنطقة، ويقتحم مفاهيمها السوق، محتلاً مكان رعاية الدولة الذي انتهى منذ عقدين. وإذا استطاع الفنانون وقتذاك الحفاظ على استقلاليتهم في مواجهة سلطة الديكتاتوريات (مصر، سورية، العراق، الجزائر… الخ)، فليس مؤكداً أنهم سينجحون في مواجهة سلطة المال.
غني عن القول أن هناك فنانين اليوم يدركون معالم المشهد وتغيراته والمخاطر المحدقة به، يقودهم وعي متراكم على الجانبين المجتمعي والثقافي، وأغلب هؤلاء ممن ينتمون إلى الأجيال السابقة من الفنانين.
وربما يكون الآن الامتحان أمام الفنانين الجدد، وأظن أنه مثلما رأينا في الأجيال السابقة سويات من الرخاوة والانتفاع والركاكة فسنراها في الأجيال الجديدة أيضاً, غير إني لست قليل ثقة في أن من بين الفنانين الجدد من يملكون وعياً بوجودهم، ومحيطهم، وعملهم أعلى من وعي الأجيال السابقة، وهم قادرون على صون إبداعاتهم، والمضي بها من دهاليز الألم إلى أعالي السماء.
* يوسف عبدلكي فنان من سوريا