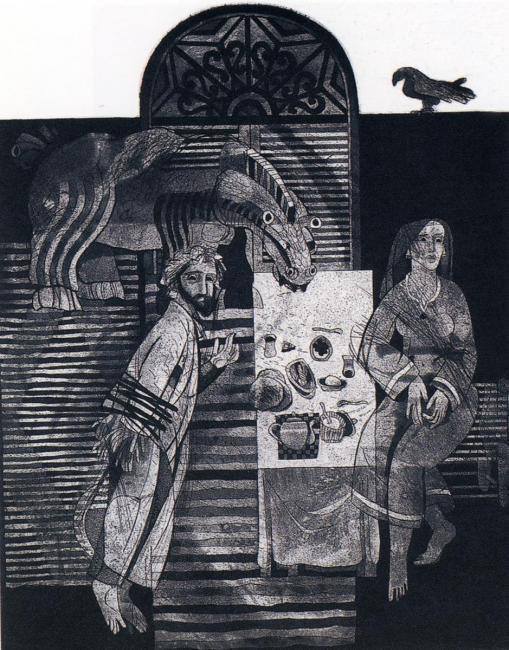يوسف، السهل الممتنع/ من منّا لا يعرف يوسف؟:فاديا لاذقاني

من الصعب إحصاء عدد أصدقاء ومعارف يوسف في باريس ودمشق والمدن التي فيها يحلّ. منذ أربعين سنة، لم أرَ أو أسمع شخصاً ممن عرفه لايحبه ولا يستمتع بالجلوس إليه في المقهى أو في مرسمه. أصدقاؤه يجمعون كل الطرق والمشارب والأعمار والأجناس. الكل يسعى إليه ويأنس في مجلسه، يحب أسلوب حديثه، يحترم كرمه وإنسانيته، ويستظرف طريقته في الأداء المطعّم بفواصل من ضحكته اليوسفية الخاصة، التي يطلقها بالترتيب الصوتي نفسه، والرنّات نفسها، حتى على نكاته. ضحكة يوسف لا تتغير، لم تتغير مذ عرفتُه سنة 1973، في أول معرض له. أشياء فيه كثيرة لم تتغير أيضاً.
يوسف يرشّ في المكان نكهة حضورٍ لا تُضاهى. كأنّ جذباً مغناطيسياً ينبعث منه، فليس لك -إن عرفتَه- إلا أن تحبه، حتى لو كنت من أشد المخالفين لآرائه. ذاك ما قال لي كثيرون. وأنا معهم فيما ذهبوا إليه.
ولكن، من منا يعرف يوسف؟
يوسف “الباستيل” و”السان ميشيل” و”الشومان فير” هو نفسه يوسف باب توما وباب الجابية ومقصف الأزروني. كلما جلستُُ إليه تراودني التساؤلات نفسها، كيف له أن يكون هو نفسه البلَد رغم حلوله في الغربة المدة كلها؟ ماذا نرى ونلمس من يوسف؟ فهو لا يفرّط بخلجاته الحميمة بل يحتفظ بها عميقاً. يجوب بك الأرض كلها، الفنّ والسياسة والأزمنة والأمكنة والشخوص، يكاد لا يفلت كلمةً واحدة عن حالته الداخلية. تخرج دائماً من جلسته مضيفاً رصيداً جديداً إلى معرفتك به، يحلو لي أن أسميها المعرفة الأفقية. وتبقى العمودية عزيزةً موصدةً بأقفالٍ لا تنال منها حادثات الروح ونكبات الأيام . يعطيك كثيراً لكنه يحتفظ بالكثير. لكن هذين “الكثيرَين” ينتميان إلى عالمَين يتجاوران متساكنَين كأنهما لا يتقاطعان.
ويوسف لايبكي!
1994، يوم رحل عنا جميل في الغربة. لم يبك يوسف. كنا قد عدنا لتوّنا من المشفى حيث يرقد جميل رقدته الأخيرة، والحزن يعصف بالتلابيب. ليوسف ولي (باعتبارنا الأكبر) قال رئيس الأطباء إنّ ساعاتٍ تفصلنا عن رحلة جميل التي ما منها عودة. يوسف صامتٌ كالحجر. حال وصولنا إلى بيته ننتظر غدر رنة هاتف المشفى المشؤوم، فاجأني يوسف بسؤاله المعتاد: كاسة شاي؟ وبكل هدوء، راح يصنعه في إبريقه الأحمر. عاد بالكؤوس ووضعها فوق الطاولة التي أنجزها بيديه من جذع شجرة، معيداً سؤاله للمرة الألف تسبقه ابتسامته: قلت لي بدون سكّر؟ ثم اتجه إلى زاوية أراشيفه وجلس إلى الطاولة. راح يعمل بكل وقارٍ بلا كلام. كأنه يقوم بعمل شيء اعتاد القيام به كلّ فجر. يضع الأوراق بعضها جانب بعض. يتناول ورقة وقلماً ويكتب شيئاً ثم يفكر فيمحوه ويعيد كتابته. كل ماقاله لي كان سؤالاً عن تاريخٍ ما للتأكد. لما انتهى أراني ماكتبه. إنها سيرة جميل وحياته ببضعة أسطر جاهزةً لوسائل الإعلام. نشرب الشاي ولا يقول يوسف شيئاً آخر. كم يجيد تحييد عصف الروح وركْنه جانباً.
ثم جاء النهار وأتى الليل ومن بعده نهارات وليلات. لم يبك يوسف جميل، ربيبه وصديق السنوات والليالي والأقرب إليه. لم يبكه يوسف أمام أحد منا.
بعد سنوات، سيفاجؤني يوسف في “مقهاه” بالباستيل بقوله من دون مناسبة: أتعرفين؟ قلما يمر يوم لا أرى فيه وجه جميل. كلما مشيت في السان ميشيل وشوراع باريس التي جمعتنا، أخاله يطل برأسه من طرف الشارع قافزاً نحوي مطلقاً شلاّلات ضجيجه وأخباره. وياما تخيلته يفتح الباب في سهرة لنا كي يشاركنا بها.
بعد زهاء خمسة وعشرين عاماً من مغادرته البلد، لما عاد إلى دمشق، كان أول مشوار قام به يوسف زيارة قبر أخيه وقبر جميل. في صمت القبور خشع يوسف طويلا. بقي رابط الجأش، لم يبك. بعد أيام، احتفل الأصدقاء والرفاق برجوعه إلى الشام، في مطعم في القلب منها، غير بعيد عن مرسمه القديم قبل المنفى. وبين الهرج والمرج، والدبكة والغناء والكؤوس ، صعق يوسف بفوفو الصغير– جميل، يتجسد أمامه شاباً مكتمل القوة، وهو الذي عرفه صغيراً يحبو. لم تنجده أقفال روحه هذه المرة، هربت منه دموعه الغزيرة وهو يعانق آلفريد الذي كبر فكان الآن أباه. انهمر بكاء يوسف المؤجّل منذ سنواتٍ عشر، فغطاه وآلفريد بحرقة ومرارة أمام الجمع المحتفِل.
حتى قصة جدته التي نجت من مذابح الأرمن. كان عليّ انتظار سنوات، أن تجود الأرض بلحظة صفاءٍ نادرةٍ من تلك التي تجعل يوسف يخوض في “الذاتي”، كي يحكيها لي. لم يحكها كلاماً فقط. لكأنه كان يغنّيها كعابدٍ يترنم بدعاءٍ مقدس. كم كان صوته حنوناً. وعيناه تشيان بشغف وحنين قامشلاويّين، وبصدى حارات طفولة راحت، وألوان دفاتر رسمه مذ كان صغيراً.
قالت لي أم يوسف وعيناها تجوبان السنين خلال طبقات الدخان المتصاعد من شفتيها: كان يوسف في بطني جنيناً عندما كنت أعبر الساقية مباعدةً بين رجليّ واسعاً، ومنتبهةً ألا يفلت مني البريد السرّي الذي لا أدري عنه شيئاً، وعليّ إيصاله من أبي يوسف إلى رفيقٍ له. ثم كان سجن أبيه مرات عديدة على عهد الوحدة. لقد أورثناه بذرة السياسة، فخبرها قبل أن يولد.
في الشام، حكى لي صديق، كان لسنوات لصيق يوسف مع صديق آخر كثلاث فلقات لا تنفصل، حادثةً أحب أن أرويها هنا.
الزمان 19٧٣ بعد حرب تشرين.
يوسف الذي يعرف كل عائلة الصديق فرداً فرداً منذ سنوات، يرافقه لمشفى المواساة، للتعرف على جثة أخ الصديق، شهيد حرب تشرين. ممرات وروائح عفنة وجثث هنا وهناك. أناس يروحون وآخرون يعودون. بعد زمن كاد الصديق أن يتراجع، لم يعد يتحمل الجوّ والزحام والفوضى، تحيط بالجثث الملقاة في المكاتب والممرات .
– فلنعدل يايوسف. نعود بعد أن يرتبوا الأمور قليلاً.
– لا يازلمة ولو؟ تعال معي.
شده من يده وأكملا. ورغم سند يوسف له، فقد خانت الصديق قواه، وكاد أن يقع مرات عديدة مغمى عليه. أصرّ يوسف على المتابعة، لا يوقفه شيء. وجهه حاسم لا يسرّب أي إحساس. زمن من المشي، الأوراق، المعاملات الاسم، المكان الولادة، العمر انتهت المعاملات القاسية التي أنجز يوسف أغلبها. خرجا من المشفى.
يحكي الصديق: كانت كفرسوسة كلها بساتين صبار. رحنا نمشي ونمشي. بعد ساعة من المشي، تخلت “أقفال الروح” عن رجُلها. اتكأ بيده على شجرة كبيرة في الحقل الكبير، أرخى برأسه على جذعها وراح يجهش ببكاء لا أنسى أصداءه ماحييت!
عندما توفي أخوه من مرضٍ لعين، بعد أن حاول يوسف أن يأتي به لعلاجه في فرنسا، لم يستطع الذهاب إلى سوريا، ككثيرين، لوداع من يحبون. هكذا يمضي الأحبة في بلد الطفولة، دون أن يستطيع المنفيون وداعهم.
ذهبتُ إليه أحمل وردة بيضاء طويلة الساق، يدثّر كياني انفعالٌ عظيم. كان في مرسمه يرسم بهدوء. يمارس خطة برنامجه اليومي الذي لايحيد عنه، بلا هوادة.
بوجل ومهابة وتأثر عانقته. وأنا أحاول إخفاء انفعالاتي و كبت دموعي.
-كاسة شاي؟ سأل سؤاله المعهود. وقام يعمل الشاي بكل آلية كما كل مرة. لم نتحدث قط عن أخيه. حدثني كالعادة عن شؤون البلد وبعض أخبار الساعة، كأني ماجئت لأعزّيه! شربت الشاي وأنا أسائل نفسي: مم صُنع هذا اليوسف الذي لاتُظهر انفعالاته أقصى النوائب؟ لم أطل مكوثي. ودعته بمثل ماكان من انفعال وقت مجيئي. أطلّ يوسف من الشباك وأخرج رأسه منه، صاح بي فرأيت بسمته العريضة وعينيه العميقتين، وهو يقول ملوّحاً بالوردة البيضاء:
– انتبهي على نفسك، لا تزعلي كثيراً. ثم أطلق بداية ضحكته المدوية بالنبرة نفسها والنظم نفسه والموسيقى نفسها، وتابع:
-شدّي حيلِك!
فاديا لاذقاني، 22 تموز، 2013
خاص – صفحات سورية