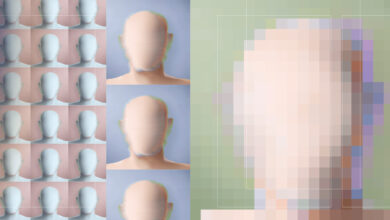مقاربات في الشعبوية ../ حسين عبد العزيز

يكاد يكون مصطلح الشعبوية من أكثر المصطلحات السياسية غموضا، فهو مائع من جهة، لأنه يفتقر إلى بنية مفهومية واضحة، ولزج من جهة أخرى، لأنه يرتبط بمقارباتٍ أيديولوجيةٍ من دون أن يتحول إلى أيديولوجيا كاملة. تتقاطع مع الكفاح من أجل البناء الوطني، ومع مضامين سياسية في لحظات معينة، ومع استياء شعبي تجاه الآخر في البيئة الوطنية، ومع القومية، فتظهر عند اليمين كما اليسار، والشعب كما النخب، وتظهر في الأنظمة الديمقراطية ـ الليبرالية والاشتراكية، كما في الأنظمة الاستبدادية. لهذا السبب، لا يوجد تعريف محدّد للشعبوية بين المفكرين الذين درسوا الظاهرة، وإن كان قاموس أكسفورد قد عرّفها بأنها “ضرب من السياسة يسعى إلى تمثيل مصالح ورغبات الناس العاديين الذين يشعرون بأن جماعات النخبة المترسخة تتجاهل شواغلهم”. وقاموس بوتي روبير بأنها “خطاب سياسي موجه إلى الطبقات الشعبية، قائم على انتقاد النظام ومسؤوليه والنخب”. ولكن هذين التعريفين لا يحيطان بالمفهوم إحاطة كاملة، وهو ما دفع عالم الاجتماع الفرنسي، برتران بادي، إلى القول إن شدة المحاولة في جعل الشعبوية نظاما موصوفا متميزا، تؤدي إلى الفشل في إيجاد أسس نظرية له. من هنا دعت ناديا أوربيناتي إلى التوقف عن المناقشات المتعلقة بماهية الشعبوية وأسبابها العميقة، والانتقال إلى دراسة نتائجها باعتبارها مشروع حكم.
تسلط هذه المقالة الضوء على خمس مقارباتٍ تناولت إشكالية الشعبوية، من حيث الأسباب التي أدّت إلى نشوئها، والنتائج التي تتوخّى إحداثها داخل البيئة السياسية.
موفي ولاكلاو
يكاد يتفق معظم دارسي الشعبوية على أنها ظاهرة موجودة في كل الأنظمة السياسية على السواء، بيد أن اهتمام الباحثين تركّز على هذه الظاهرة داخل البلدان الديمقراطية ـ الليبرالية، لأنها أكثر وضوحا، ولأنها ناجمة عن أسباب موضوعية شبه مستدامة في ظل النظام السياسي القائم.
تعتبر عالمة الاجتماع البلجيكية شانتال موفي أن الوضع الذي تعيشه البلدان الديمقراطية ـ الليبرالية يمكن تسميته “ما بعد الديمقراطية”، لأن التوتر بين الديمقراطية والليبرالية قد انتهى بعد انتصار النيوليبرالية (تمدّد القطاع المالي على حساب القطاع الإنتاجي، تزايد الخصخصة) وإخماد الديمقراطية التي تحولت إلى احتفال بالانتخابات فقط.
تدرك موفي، منذ البداية، صعوبة الجمع بين التزام التعدّدية الاجتماعية والتزام المساواة بمتانة، لأن البنى المصمّمة لتعزيز المساواة تقيد الالتزام الأول. ولكن انتصار النيوليبرالية بهذا الشكل، وما نتج عنها من نشوء أوليغارشية فجّة، جعلها من أنصار الدعوة إلى إعادة بناء “الديموس”، وهذا لا يحصل إلا بتدخلٍ سياسي شعبوي، من أجل إعادة القوة إلى ديمقراطيةٍ تنادي بالمساواة من دون إلغاء التعدّدية.
مقاربة شانتال متأثرة بالتأكيد بنظرية لاكلاو (زوجها) الذي يعتبر الشعبوية مقاربة إيجابية، لأنها تنتج هوية جمعية، تجعل السياسة ممكنةً لفئةٍ كبيرةٍ في المجتمع، لمواجهة خطر البيروقراطية وخطر استبداد الأوليغارشية.
يؤكّد لاكلاو وموفي أن الديمقراطية ـ الليبرالية هي سبب نشوء الشعبوية، وأن الديمقراطية الراديكالية (ديمقراطية الشعب أو الديمقراطية المباشرة) هي الحل، لأنها تتجنّب المذهب الاستبدادي المرتبط باليقين الحديث بوجود حقيقة وقيمة مطلقتين من جهة، وبتصدّع التضامن الاجتماعي وتفكّكه المرتبطين بالألعاب اللغوية لما بعد الحداثة من جهة أخرى، وفق كلمات كيث ناش.
بالنسبة لـ لاكلاو، يوجد شرطان لنشأة الشعبوية: نشأة السلسلة المتكافئة من المطالب، ونشأة الحد التخاصمي بين السلطة وسلسلة المطالب، ثم حصول توحيد رمزي لسلسلة المطالب. بعبارة أخرى، تنشأ سلسلة من المطالب الاجتماعية المختلفة في وجه السلطة. وعند هذه المرحلة لا تنشأ الشعبوية، لأننا أمام مجرد مطالب، وعندما يحدث توحيد رمزي لهذه المطالب مجتمعة، تحدث خصومة حادّة مع السلطة، هنا تنشأ الشعبوية. ولكن هذه المعطيات الثلاثة تتوفر في أية انتفاضة شعبية ضد النظم الاستبدادية، وبالتالي هي غير كافية لتحديد التمايز بين الشعبية والشعبوية. وقد تنبه إلى ذلك المفكر السلوفيني سلافوي جيجك الذي كان ردّه على لاكلاو عاملا مساعدا في فهم نظرية الأخير. يرى جيجك أن العناصر الثلاثة التي تحدّث عنها لاكلاو لنشوء ظاهرة الشعبوية لا تكفي لوصف أي حركة اجتماعية بوصف الشعبوية، فهناك حركاتٌ اجتماعيةٌ لم تكن شعبوية، مثل حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. يرد لاكلاو أن هذه الحركة لم تُحدث خصومة سياسية مع السلطة، وبالتالي لا يمكن أن تكون استراتيجية سياسية للقوى الديمقراطية.
تطرح نظرية لاكلاو إشكالات كثيرة، لأن فكرة الحد التخاصمي بين فئة اجتماعية من جهة والسلطة من جهة أخرى، كانت حالة متوفّرة في كل الحركات أو الانتفاضات الاجتماعية، خصوصا في الأنظمة الاستبدادية، وفي الأنظمة الديمقراطية الناشئة. الغريب في مقاربة لاكلاو أنه في وقتٍ يؤكّد فيه أن منشأ الشعبوية كان نتيجة التوتر بين الديمقراطية والليبرالية، يقدم حلا من خارج السياق الديمقراطي ـ الليبرالي، حيث يعتبر أن حل التوتر بين الديمقراطية والليبرالية لا يكون إلا من خلال نضال وصراع حاد ضد النخبة الحاكمة، وليس من خلال الحوار العقلاني.
من الواضح أن فكرة الصراع ناجمةٌ عن الخلفية الماركسية للاكلاو، وناجمة أيضا عن معاينته التجربة السياسية في أميركا اللاتينية، حيث كان الصراع ضد النخب السياسية ـ الاقتصادية حادا.
موده وكالتواس
يتفق كاس موده وكالتواس مع لاكلاو وموفي في أن الشعبوية هي نتاج الأنظمة الديمقراطية ـ الليبرالية، وأنها رد فعل ديمقراطي على التجليات غير الديمقراطية لليبرالية، ويتفقان معهما أيضا في أن الشعبوية ديمقراطية في جوهرها، ولها بعد إيجابي (مشاركة جمهور الناخبين في السياسة)، وإن كانت تختلف عن الأنموذج الديمقراطي ـ الليبرالي السائد، من حيث أنها ترفض تقييد إرادة الشعب، وترفض فكرة الليبرالية القائمة على التعددية. ولكن موده وكالتواس يختلفان مع لاكلو وموفي في اعتبار أن للشعبوية منطقا سياسيا، وأنها تعيد الحياة للديمقراطية، فبرفض الشعبوية الليبرالية، قد ننتهي بنزعة استبدادية هوياتية تدمر النظام السياسي القائم. وبالنسبة لـ موده تحديدا، التقسيم الأخلاقي للعالم هو السبب في نشوء الـ “نحن”/ “الشعب”، مقابل الـ “هم”/ “النخبة”، الأولى خيرة والثانية فاسدة. وعلى الرغم من ذلك، يرى موده وكالتواس أن الشعبوية قد يكون لها تأثير إيجابي في الديمقراطيات الناشئة في الأنظمة الديمقراطية ـ الليبرالية المتطوّرة.
وفي حالة الديمقراطيات الناشئة، ثمّة أثر إيجابي للشعبوية، خصوصا في المرحلتين، الأولى والثانية، من عملية الانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي.
في المرحلة الأولى، تطبيق الليبرالية، تبدأ الشعبوية في تطبيق الليبرالية، حين يرفع نظام استبدادي بعض القيود، ويوسّع بعض الحقوق الفردية والجماعية، وهي من هذا الجانب عامل إيجابي للديمقراطية. وفي المرحلة الثانية، مرحلة الانتقال من الليبرالية إلى الديمقراطية، تلعب الشعبوية دورا إيجابيا، بسبب دفاعها عن مبدأ انتخاب الناس لمن يحكمهم.
أما تأثير الشعبوية في الأنظمة الديمقراطية ـ الليبرالية، فهو إيجابي وسلبي، فهي من جهة تكون مصححة لمسار الديمقراطية من حيث إسماعها صوت جمهور الناخبين الذين لا يشعرون بأن النخبة تمثلهم. ومن جهة ثانية، تؤثر الشعبوية سلبا من خلال ادّعائها عدم أحقية أي مؤسسة في تقييد حكم الأغلبية، وهي عمليةٌ قد تنتهي بالقوى الشعبوية إلى مهاجمة الأقليات، وتقويض جهد المؤسسات المتخصصة في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وإن كان موده وكالتواس يستبعدان حصول ذلك بسبب قوة النظام الديمقراطي ـ الليبرالي.
لا تسعف هذه المقاربة في تحديد الفرق الجوهري بين الشعبي والشعبوي، فوفقا لمقاربة موده وكالتواس، يصبح كل ضغط شعبي على الأنظمة الاستبدادية ظاهرة شعبوية، وتصبح كل حركة اجتماعية ـ سياسية مناهضة للاستبداد أو داعية إلى تصحيح العلاقة المتوترة بين الديمقراطية والليبرالية، هي حركة شعبوية. ومع أنهما أوضحا في مقدمة كتابهما “مقدمة مختصرة في الشعبوية” أن دراستهما الشعبوية تأتي من منظور ديمقراطي ـ ليبرالي، لأن الشعبوية تتضح إذا ما قورنت بالديمقراطية ـ الليبرالية، فإن تمظهر الشعبوية في معاداتها البعد الليبرالي، قد يوضح تجليات الشعبوية على مستوى الخطاب السياسي، لكن لا يوضح الأسباب العميقة للظاهرة.
فيرنر مولر
عمل فيرنر مولر على تكثيف مفهوم الشعبوية، من أجل تمييزها عن الظواهر السياسية الأخرى المشابهة، فلا يجب أن نستخلص منها أساسا قوميا أو عنصريا. ولا يجب ربطها بالزعامة، ولا يمكن معرفة الشعبويين من خلال معرفة ناخبيهم في أسفل الطبقة الوسطى، ولا يمكن اعتبار نقد النخبة معيارا كافيا لتحديد المفهوم، ولا يمكن اعتبار معاداتها التعدّد سمة خاصة بها.
وفي مقابل هذه التوضيحات، يقدم مولر سماتٍ تميز الشعبوية: ادّعاء أنهم يمثلون إرادة الشعب من أجل ضرب المؤسسات الديمقراطية التي لا يسيطرون عليها، رفض الشعبوية التعدّد (الليبرالية)، رفضها النخبة الحاكمة، رفضها البرلمان بوصفه مؤسسة وسيطة، تحويل عملية التمثيل السياسي إلى عملية تفويض كامل.
لا تظهر هذه السمات إلا في الأنظمة الديمقراطية ـ الليبرالية. ولذلك يعتبر مولر أن ظاهرة الشعبوية ستبقى ما بقيت الديمقراطية قائمة، وأنها ظاهرة معادية ليس فقط لليبرالية، بل أيضا للديمقراطية (بخلاف لاكلو وموفي وموده وكالتواس) لأن الشعبوية تضع سيادة الإرادة الشعبية فوق كل شيء، وتجري تقسيما أخلاقيا بين “نحن” و”هم”، تقسيم سرعان ما يحمل بعدا أخلاقيا ومن ثم هوياتيا، في عودة ما ورائية إلى ما قبل مكيافيلي لربط السياسة بالأخلاق ربطا محكما.
الشعبوية هي انعكاس لسياقاتٍ ثلاثة غير مسبوقة تعيشها الديمقراطية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية: سياق الإشكالية السياسية التي طرحتها النازية بديلا للمؤسسات الديمقراطية، من داخل الديمقراطية ذاتها التي كانت حكومة فايمار تجسيدا لها. سياق شعبوي نشأ في أوروبا الشرقية ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ووجّه نقده إلى الاتحاد الأوروبي كمؤسسة محكومة من بيروقراطية غير منتخبة، تفتقر لأي بعد ديمقراطي. سياق الأزمة المالية ـ العقارية في الولايات المتحدة عام 2008، وما فرضته من سياسات تقشف أثّرت سلبا على فئات اجتماعية كبيرة.
تؤكد هذه السياقات الثلاثة، وفقا لمولر، أن الشعبوية ارتبطت بالديمقراطية في سياق تاريخي خاص، وهو الأمر الذي جعلها تتميز عن التيارات السياسية المعارضة للديمقراطية أو المنافسة لها، فليست كل التيارات المعادية أو المنتقدة للديمقراطية شعبوية، وليست كل التيارات التي تتحدّث باسم الشعب شعبوية، فما يميزها عن التيارات السياسية أن الشعبوية تعارض الديمقراطية من قلب فكرة الديمقراطية نفسها.
ناديا أوربيناتي
ليست الشعبوية أيديولوجيا أو نظاما سياسيا محددا، بل هي سيرورة تمثيلية، تتكوّن عبرها ذات جمعية، بحيث يكون في مقدورها الوصول إلى السلطة. تحاجج أوربيناتي في أن الديمقراطية الشعبوية اسم نمط جديد من الحكم التمثيلي، يرتكز على ظاهرتين: علاقة مباشرة بين الزعيم وأولئك الذي يعرفهم الزعيم بأنه صالحون أو أخيار. تخويل سلطة مفرطة لجمهور المتلقين، وأهدافها المباشرة هي العقبات التي تعترض تطوّر هاتين الظاهرتين: هيئات صنع الرأي الوسيطة (الأحزاب، وسائل الإعلام، الأنظمة ذات الطابع المؤسسي المخصصة لرصد السلطة السياسية ومراقبتها). تنامي أوليغارشية مستفحلة وجشعة تجعل السيادة سرابا.
الشعبوية إذا، مشروع حكمٍ جديدٍ للحكم التمثيلي، إلا أنه مشوّه، لأنه يبعد المعارضة ويجعل السياسة غير ممكنة. وهذا لا يتحقق إلا بإجراء تحويل في ركائز الديمقراطية الحديثة الثلاث: الشعب، مبدأ الأغلبية، التمثيل، وهذا هو هدف كتابها “أنا الشعب: كيف حوّلت الشعبوية مسار الديمقراطية”.
تتفق ناديا أوربيناتي مع نقد جيجك لاكلاو بأن من غير الصحيح التعامل مع الشعبوية بوصفها متطابقة مع الحركات الشعبية أو الاحتجاجية، إذ قد تتضمّن الحركات الشعبية بمفردها خطابا شعبويا، لكنها لا تمتلك مشروع سلطة شعبوية. ثمّة فرق بين حركات ديمقراطية معترضة على اتجاه اجتماعي يرى المواطنون المعبأون خيانة للمبادئ الأساسية للمساواة، ومقاربة شعبوية تسعى إلى التغلب على المؤسسات التمثيلية والفوز بأغلبية حكومية من أجل نمذجة المجتمع وفق أيديولوجيتها الخاصة بالشعب.
وفي سياق ردّها على نظرية لاكلاو وموفي، تتوجه أوربيناتي مباشرة إلى القول إن بنية الشعبوية لا تميل من تلقاء نفسها إلى نوع من السياسة التحرّرية، مهما حاول يساري، مثل لاكلاو، ترويجه. وإذا وصفت الديمقرطية بأنها إستراتيجية للظفر بالسلطة قائمة على القبول، ينتهي توصيف لاكلاو الشعبوية باحتواء السياسة الديمقراطية عامة، ووفقا لرؤية لاكلاو تصبح كل السياسات شعبوية.
تتفق أوربيناتي مع مولر في اعتبار الشعبوية مضادّة للديمقراطية، لكنها ترفض حججه، فالتقسيم المانوي الأخلاقي الذي وضعه مولر وكوده وكالتواس في صلب الشعبوية “نحن” و”هم”، لا يفسّر خصوصية الشعبوية، ذلك أن “نحن” و”وهم” هي محرّك أنماط التجمع الحزبي كافة، وإن كان ذلك بكثافاتٍ وأساليب متباينة، فضلا عن أن فقدان الثقة في من يتولون السلطة وانتقادهم هما مكونان من المكونات الأساسية في الديمقراطية، ولا يفسّران الشعبوية.
وترفض أوربيناتي مقاربة موده وكالتواس في أن الشعبوية تعادي النموذج الديمقراطي ـ الليبرالي فقط، ولا تعادي الديمقراطية في ذاتها، فمن وجهة نظرها إن التمييز بين الديمقراطية والليبرالية في الأنظمة المعاصرة لا يوضح منشأ الشعبوية، لأن الديمقراطية تحيل إلى مزيج من السيادة الشعبية وحكم الأغلبية، وإن إسناد قيمة الحرية إلى الليبرالية لا إلى الديمقراطية يعجز عن توضيح العملية الديمقراطية نفسها.
ومن منظور ثنائية الحكم الذي تعتمده، تدحض أوربيناتي الحكمة التقليدية التي تُفهم الشعبوية وفقها بوصفها ديمقراطية غير ليبرالية، فديمقراطية تنتهك الحقوق السياسية الأساسية، وتمنع تشكل أغلبيات جديدة ليست ديمقراطية على الإطلاق. ولذلك التمييز بين ديمقراطي وديمقراطي ـ ليبرالي فعل مضلّل.
يكمن القصور الرئيسي في المقاربات الأيديولوجية في حقيقة أنها لا تولي اهتماما كافيا بالجوانب المؤسسية والإجرائية التي تتّصف بها الديمقراطية وتظهر الشعبوية ضمنها. لا توضح هذه المقاربات، وفقا لأوربيناتي، ما الذي يجعل تركيز الشعبوية المتصل بمناهضة مؤسسة الحكم مختلفا عما نجده في الباراديغم الجمهوري، أو في السياسة المعارضة التقليدية، أو حتى في التحزّب الديمقراطي؟
عزمي بشارة
قد يبدو الخلط بين الشعبية والشعبوية مفهوما إلى حدّ ما في الأنظمة الاستبدادية والأنظمة التي تنتقل نحو الديمقراطية بسبب صعوبة تلمّس الظاهرة بعيدا عن الحالة الشعبية الغاضبة، وهي مسألة حرص عزمي بشارة على تأكيدها في مقدمة كتابه “في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟” (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019)، حين قال “ليست كل استراتيجية شعبية هي شعبوية، لكنها قد تتضمّن عناصر شعبوية”، لكن الخلط بين الشعبية والشعبوية في الأنظمة الديمقراطية ـ الليبرالية يبقى غير مفهوم. لم تكن مهمة كتاب عزمي بشارة “في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟” تقديم سرد نظري للشعبوية، بقدر ما هي قراءة للبنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلدان والمجتمعات المتطوّرة، بحيث لا يمكن فهم الشعبوية من دون فهم آليات عمل النظام الديمقراطي ـ الليبرالي ومشكلاته. إنها علاقة جدلية: تُفهم الشعبوية من خلال فهم النظام الديمقراطي ـ الليبرالي، بقدر ما تُفهم مشكلات الأخير من خلال الشعبوية، كتجلٍّ للتوتر الدائم في هذه الأنظمة.
يتفق بشارة مع دارسي الشعبوية في أنها نتاج للتوتر بين التقليدين، الديمقراطي والليبرالي، لكنه يغوص أكثر في فهم الميكانيزمات الاجتماعية والسياسية لهذا التوتر. ويحدد عناصر الأزمة في النظام الديمقراطي ـ الليبرالي بثلاثة توترات بنيوية:
1ـ التوتر القائم بين البعد الديمقراطي المتعلق بالمشاركة الشعبية القائمة على افتراض المساواة الأخلاقية بين البشر وافتراض المساواة في القدرة على تمييز مصلحتهم التي تقوم عليها المساواة السياسية من جهة، وبين البعد الليبرالي القائم على مبدأ الحرية المتمثلة في الحقوق والحريات المدنية من جهة ثانية.
2ـ توتر داخل البعد الديمقراطي ذاته، بين فكرة حكم الشعب ذاته وضرورة تمثيله في المجتمعات الكبيرة والمركبة عبر قوى سياسية منظمة ونخب سياسية.
3ـ توتر بين مبدأ التمثيل بالانتخابات الذي يقود إلى اتخاذ قرارٍ بأغلبية ممثلي الشعب المنتخبين، أو بأصوات ممثلي الأغلبية من جهة، ووجود قوى ومؤسسات غير منتخبة ذات تأثير في صنع القرار (الأجهزة البيروقراطية للدولة) من جهة أخرى.
ليست هذه التوترات عابرة، بل هي دائمة وجزء رئيسي داخل منظومة العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية. لكن في حين اعتبر مولر أن هذه التوترات الثلاثة هي سبب نشوء الشعبوية، لا يعتبر عزمي بشارة أن هذه التوترات في ذاتها سبب لنشوء الشعبوية، لأنها لا تؤدي تلقائيا وبالضرورة إلى غضب قطاعات اجتماعية، أو إلى نشوء خطاب شعبوي، فغالبا ما لا يفكّر الناس في هذه التوترات.
هنا، ينتقل بشارة إلى البنية الاجتماعية ـ الاقتصادية، فالتفاوت بين المساواة الاجتماعية والمساواة السياسية، وفجوات توزّع الدخل وتشوهه، وإشكالية الحرية في غياب المساواة الاجتماعية، ومسألة الهويات والحقوق الجماعية، والثقافة والتقاليد السائدة، هي مصدر التهميش ووجود فئات متضررة وأخرى مستفيدة من النظام. وتتغذّى الأزمة بتعمق اللامساواة مع انهيار إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية على دولة الرفاه وهيمنة النموذج النيوليبرالي وتضرّر الطبقة الوسطى والعمال الصناعيين. ولذلك ينبه بشارة الباحثين الليبراليين الذين شخّصوا خطر الشعبوية في تشويه تقاليد المساواة بتحويلها إلى قيم مطلقة، في أنهم لم يولوا الاهتمام الكافي بمعالجة المصادر الاجتماعية والثقافية للشعبوية.
وافق بشارة على مقاربة ديفيد غودهارت في أهمية مسائل الهوية والانتماء والثقافة في تفسير الشعبوية. وقد ميز غودهارت بين فئتين اجتماعيتين في الغرب الديمقراطي: تنتمي الأولى إلى بيئة محلية، وتحافظ على قيمها وتقاليدها، ويتسم أعضاء هذه الفئة بأنه لم يغادروا بيئتهم المحلية. والثانية هي فئة اللامحليين أو المتنقلين الذين لا ينتمون إلى مكان محدّد، وبسبب تنقلهم المستمر بحكم عملهم، تفاعلوا مع الثقافات الأخرى.
الفئة الأولى، هي التي ترفض الغريب والطارئ. ولذلك هي الأكثر تعرّضا لخطاب الشعبوية، خصوصا في جانبه المضاد للهجرة، في حين أن الفئة الثانية غير قلقة من الهجرة والاندماج. وقد دافع غودهارت عن الفئة الأولى من خلال دعمه الشعبوية اليمينية، فما يجب حمايته ليس حقوق الفرد، وإنما حقوق الجماعة والأعراف والتقاليد الأصلية. وينتقد بشارة الحلول التي قدّمها غودهارت، لأنها تعني أن معركة التعدّدية الثقافية ستكون خاسرة، وأن اليسار يجب أن يتبنّى سياساتٍ ثقافيةً إثنيةً كي يجتذب هذه الفئة بعيدا عن اليمين الشعبوي. ويتجاهل هذا الرأي أو التيار أيضا، بحسب بشارة، أهمية الحقوق الاجتماعية ورفع مستوى التعليم في مقابل التشديد على تعظيم عنصر الثقافة.
فكرة المحلوية غير كافية لتفسير الشعبوية، الأمر الذي دفع بشارة إلى توجيه نقد لتحديدات موده الشعبوية في المحلوية والسلطوية وعدم الثقة بالنخب، لأن ثالوث السياسات الشعبوية هذا في المجتمعات المتطوّرة يجمع بين أحزاب كثيرة في أوروبا، وبالتالي تصبح الشعبوية غير مختلفة نوعيا عن التيار المركزي.
يسلط بشارة الضوء على التداخل الحاصل بين الشعبوية والحركات الاجتماعية الشعبية، ويأخذ على ذلك مثال عملية وضع الحدود لسلطة الدولة، فيقول إن عملية تحديد سلطة الدولة لم ترتبط بالليبرالية فقط، فالحركات الاجتماعية مثلت، في ظل النظام الديمقراطي أيضا، توجها لتحديد سلطة الدولة من خلال إعادة الحياة لسلطة المجتمع المدني. وهذا يقتضي أن ثمّة استنتاجات غير شعبوية مستخلصة من الاغتراب عن المؤسسات والقيادات السياسية، إذ تُطرح صيغ من الديمقراطية غير المركزية في البلديات الصغيرة ووحدات الإنتاج الصغيرة وتستخدم البلاغة الشعبوية، لكنها ليست شعبوية، لأنها لا تمتلك أيديولوجيا تعتبر الشعب خيرا في حد ذاته.
فكرة الشعب بأنه خير في ذاته مقابل النخبة، قد تنتهي إلى نشوء الـ “نحن” مقابل الـ”هم”، إذا زاد منسوب الكراهية وشيطنة الآخر، وهنا ثمّة فرق بين رؤية بشارة الـ”نحن” و الـ”هم”، مغايرة لرؤية موده وكالتواس.
بالنسبة لبشارة، ليست الرؤية الأخلاقية للعالم عند فئة اجتماعية معينة سبب نشوء الـ”نحن” مقابل الـ”هم”، فهذه الثنائية هي نتاج الخطاب الشعبوي، أو بالأحرى هي أحد أشكالها الأخيرة، فليس ثمّة موقف أخلاقي حدي مكتمل وناجز عند فئة اجتماعية قبيل نشوء الخطاب الشعبوي من البنية الفوقية (الزعيم أو الأحزاب السياسية).
العربي الجديد