«عزازيـل» بوكـر.. مـاذا تربـح الروايـة؟
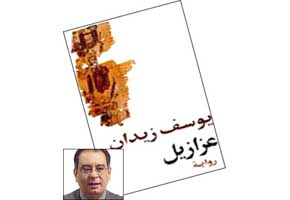
عباس بيضون
ميزة جائزة بوكر على غيرها من الجوائز العربية المعروفة انها تمنح لرواية تصدر في عامها لا لأثر كامل، إنها ميزة ينبغي احترامها. روايات العام هي التي في المسابقة لا أصحابها. هكذا نفهم أن «مديح الخيانة» كان في الميزان لا خالد خليفة وبهاء طاهر. نفهم أيضاً أن رواية «عزازيل» ورواية «الجوع» في الميزان لا يوسف زيدان ومحمد البساطي. ان رواية «عزازيل» فازت على «الجوع» لا يوسف زيدان على محمد البساطي، جائزة كهذه يمكنها ان تتدخل، ان ترفع رواية أو أن تبرز كاتباً. أقدر تبعا لذلك أن تمنح الجائزة للأقل شهرة وأن تضع في حسابها شعبية الكتاب والردود التي أثارها، أعرف أن الجائزة لا تصنع كاتباً بقدر ما تصنع كتاباً فقد منحت «غونكور» لكتّاب في أول عهودهم وفاتت كتّاباً مكرسين ولم تدركهم الا وقد جعلتهم شهرتهم امامها، بل قد يكون من محاسن الجائزة أحياناً ان تقدم كاتبا فتيا على متمرس، فهكذا تغدو الجائزة أفعل، فما تكون فائدتها اذا كانت لا تكرس الا المكرسين ولا تطلع الا بالمعروف المتوقع.
هذه المقدمة لأقول إنني من حيث المبدأ مع ما قررته اللجنة. تقديم الرواية لا الكاتب واختيار الأفتى على المتمرس، من حيث المبدأ فقط، اذ ان اختيار «عزازيل» اكثر من مسألة مبدأ.
فضل رواية «عزازيل»، كما سبق ان قلت في مقال سبق، انها فتحت، او كادت ان تفتح، باباً في الرواية جديداً. لنقل انه باب الرواية الثقافية اذاجاز القول. انها رواية اركيولوجيا ثقافية. مثل هذه الرواية مفقود في أدبنا الحديث ويوسف زيدان رائد، او يكاد فيها. أقول يكاد لأنني أعرف أنه مسبوق برواية أقوى حبكة وأمتن روائية هي رواية «لغة السرّ» لنجوى بركات التي مرّت بصمت نسبي ولم تثر ما أثارته «عزازيل» من ردود او رواج، لم يكن لبركات حظ عزازيل لسبب صريح هو ان النقاش التيولوجي الذي تستعيده الرواية حول طبيعة المسيح هو نقاش لم يمض ولا يزال قيد استهلاك يومي. في مجتمع متعدد دينياً، اسلامي مسيحي، كالمجتمع المصري لا تزال الوهية المسيح والأخذ والرد عليها مسألة راهنة. انها خبز المجادلة الاسلامية المسيحية الحاضرة كل ساعة في المساجد والحلقات والمناقشات. لا يقل لي أحد إن المجتمع تعداها. يكذّب ذلك الحضور اليومي للجدل اللاهوتي والديني في المجتمع، والاحتكاكات المستمرة بين المسلمين والمسيحيين. لم تبتعد «عزازيل» عن هذه الملاسنة. صحيح انها رواية عن العهد المسيحي القديم، لكنها تنفذ فورا الى المماحكة الطائفية الحاصلة، الطائفية نعم لماذا لا نقولها جهراً. لا تستطيع الرواية أن تنأى بنفسها عن هذا المزلق ولا بد أنها سقطت فيه من اللحظة الأولى. مع ذلك ينبغي ألا نخضع لارهاب كهذا على موضوعات او قضايا لمجرد الخوف من ان تثير حساسيات او توضع موضع الاستغلال. لكنت قلت هذا ووقفت عنده لولا اعتبارات شتى. منها ان الكاتب، كما علمت فيما بعد، مسلم، وهو في هذه الرواية منسجم مع إسلامه، فهو يتبنى أريوس ونسطور في مذهبهما الذي لا يختلف عن فهم الاسلام لطبيعة المسيح. ذلك يعني ان الجدل الاريوسي النسطوري يمكن أن ينقلب فوراً الى مجادلة اسلامية للمسيحية. عند ذلك لن يكون يوسف زيدان، شاء أم أبى، سوى مسلم يتوسل الاريوسية والنسطورية لتثبيت رؤية الاسلام لطبيعة المسيح.
أضف إلى ذلك إن الأقلية المسيحية وهي بالملايين في مصر. والاختلاف على عددها ونسبتها لا يبرأ من مضمون أهلي، هذه الأقلية لا تزال منذ ثورة 1952 مقصية مهملة إن في السلطة او البرلمان. يكفي ان نذكر أن أغلب نوابها من حصة الرئيس ويعينون ولا ينتخبون. أقلية كهذه لا تحتاج إلى من يحاصرها في دينها وإيمانها وخاصة في المحل الذي دار فيه صراعها التاريخي العقائدي مع الآخر المسلم. القول بأن التثليث عقيدة فرعونية وأن شطراً من الكنيسة المسيحية الأولى لم يكن يؤمن بألوهية المسيح يدعم نظرية الاسلام في تزوير الانجيل. الغريب أن رواية عزازيل سمح لها بالنشر مراراً في بلد تمنع فيه الرقابة الاسلامية ديوان شعر بعنوان «لا نيل الا النيل»، لأنه يحاكي في اللفظ «لا إله الا الله» ويفتي بحرمة زواج نصر حامد ابو زيد لرأي مخالف في فهم النص الديني. أليس في هذا وزن بميزانين. ثم ألا يخشى في بلد يغلي بالجدل الديني ان تستغل رواية «عزازيل» لاذكاء العصبية والطائفية وأن تجد نفسها في حومة نقاش غوغائي لم تستعد له.
شعبية الرواية ونشرها في طبعات عدة سبب /من أسباب/ في تبنيها واعتمادها للجائزة، لكن من قال ان كل من قرأوها قرأوها كرواية، وأن الاقبال عليها كان فقط لمعالجتها الروائية. الا نظن ان الجدل الديني الذي أثارته كان جذاباً لمزيد من القراء، ألم يقرأها مسلمون كثر ليجدوا فيها سنداً لأطروحتهم وقرأها مسيحيون لسبب معاكس، وأين دار النقاش حول الرواية، هل دار حول فنيتها أم دار أكثر في الجانب الآخر. كانت رواية «اسم الوردة» التي استلهمها يوسف زيدان في النقاش التيولوجي وفي الاركيولوجيا التاريخي تتوسل النقاش التيولوجي للانتصار للتفكير الحر، فهل يفعل اتهام المسيحية باسم العقل كما في رواية «عزازيل» شيئا من هذا؟ هل ينتصر للعقل فعلاً، أم يقع واعيا أم غير واع، في نزاع مفتوح على كل ما عدا العقل؟
ترى هل يجرؤ مسيحي مصري على أن يخوض على النحو نفسه في اللاهوت او السنة او السيرة الاسلامية؟ وهل سيجد من يدافع عنه باسم الحرية او يمنحه جائزة؟ ثم ما هو العمق الثقافي والاركيولوجيا الفكرية في معالجة ان اتسمت بشيء فهو العامية الفكرية، ليست فكرة يوسف زيدان عن العقل والتيولوجيا سوى أن الثلاثة لا تكون واحدا والله لا يكون انساناً، كل تاريخ الميتافيزيقا واللاهوت والهرطقة لا يزيد عن هذا المنطق الحسابي، انه يناقش الدين باسم عقل بسيط ليس عقلاً فلسفياً ولا لاهوتياً ولا تاريخياً. بل يناقش الايمان المسيحي بـ«كليشيه» عقلي و«كليشيه» لاهوتي. ذلك لا يزيد كثيراً عن عقل الشارع الطائفي وعن حججه وعن منطقه، واذا اتسم بشيء فهو ادقاع لاهوتي وفكري.
اما المعالجة الروائية فلا أعرف فضلها في رواية «عزازيل». لا بد ان القارئ يجد متعة في الاكزوتيكا التاريخية في الرواية. وصف الأديرة والاحتفالات الوثنية ودروس هيباتيا وحكاية اوكتافيا، بيد ان هذه الاكزويتكا لا تتفتح كما ينبغي ونجد انفسنا أحيانا في واقع لا طبيعة الله ويزول فيه، وبسرعة، «السحر التاريخي». ثم أن لغة الرواية نموذج على هذه الحيرة، لا يجد يوسف زيدان لغة عربية موازية للارليوكوجيا التاريخية. أو انه لا يبحث عنها. لا يحاول ان يستفيد من لغة الروايات العربية: لغة الاصفهاني او المقريزي او الطبري. او لغة الفقه او النحو او تحقيق الحديث، وهو في الوقت نفسه لا يلجأ الى لغة «حديثة». يريد للكلام إيحاء تاريخياً لا موضع له ولا مصدر فيغرق في لغة اصطلاحية منمقة ليس فيها سوى رخاوة أساليب ما سُمّي بعصر النهضة ومطاطيتها. هكذا يسـتدعي الزيـداني الأول «جورج»، لكن في غير وقته.
يسعدني كما قلت في البدء أن تمنح الجائزة لرواية لا لكاتب وأجد مثلاً طيباً في تجاوز كاتب متمرس لمصلحة آخر متمرن على حد قول الجاحظ، لكن تجاوز روائي كمحمد البساطي لا يبدو من هذه الطبيعة، إنه تقريباً غبن متواتر وليس هذا هو التجاوز الأول. لأمر ما يتم هنا تجاهل آخر لواحد قد يكون أهم كتاب جيله. اذا كانت بادرة تقديم المتمرن على المتمرس مرضية من حيث المبدأ إلا انها ليست مرضية هنا. تفضيل «عزازيل» على أي من أعمال البساطي ليس سوى استخفاف بالفن الروائي. والرواية والأدب لا يربحان من هذا الباب. ما يربح هو عامية روائية وعامية فكرية، ولو تحت مظهر التجديد.
السفير الثقافي
يوسف زيدان: روايتي لامست الواقع
أبطل فوز رواية «عزازيل» للكاتب يوسف زيدان تكهنات كثيرة حول استبعاد فوز أديب مصري للمرة الثانية في دورة جائزة «بوكر» العربية الثانية.
ذهبت الجائزة العام الماضي إلى الأديب بهاء طاهر، وجاء فوز زيدان ليؤكد حيادية الجائزة وأنها لا تخضع لمعايير جغرافية وتنظر بحسب الناقدة اللبنانية يمنى العيد إلى المنجز الأدبي وقيمته فحسب.
عقب فوزه أكد زيدان في اتصال مع «الجريدة» خلال وجوده في أبو ظبي أن الضجة التي أثارتها الرواية طوال العام الماضي لم يكن لها دخل في حيثيات فوزه، معبراً عن سعادته بالجائزة والتي لم يتوقع الفوز بها. ورفض إطلاق اسم عمل وثائقي أو تسجيلي على روايته، قائلاً إنها رواية أدبية تحوي شخصيات متلامسة مع الواقع.
«عزازيل» روايته الثانية بعد «ظل الأفعى»، نسج زيدان تفاصيلها بخيال ثري التحم مع وقائع تاريخية محققة، فأثيرت ضجة كبيرة ضدها من الكنيسة المصرية لأنها اقتحمت منطقة طُمست بتعمّد فترات طويلة.
وليس غريباً على زيدان اللجوء إلى التراث والمخطوطات «عزازيل»، إذ تنوعت أعماله بين الأدب والتأليف والتحقيق والفهرسة. وفي بداياته اتجه إلى التراث الروحي الفسيح «التصوف» الذي تمتزج فيه الفلسفة بالدين، متأثراً بنشأته في الإسكندرية في كنف والده المتصوّف.
تدور أحداث «عزازيل» في غمار أزمة وجودية صاحبت البطل الراهب «هيبا»، وانقسام نفسه بين الإيمان بتجلياته وحب الحياة بأعمق بتفاصيلها، لتتجلى الطبيعة الإنسانية بقوة الإيمان وأضعف اللحظات، وإمعاناً في الإثارة اعتمد المؤلف الذي يدير مركز ومتحف المخطوطات في مكتبة الإسكندرية بإقحام «هيبا» في غمار أحلك العصور المسيحية القديمة، تلك الفترة التي اتسمت بالغموض وندُر الحديث عنها لاعتبارها تاريخاً يخص الكنيسة وحدها.
يروي زيدان، كما جاء في موقعه الإلكتروني: «سمعت في حضن الجبل صوت منشد أسطوري اسمه ياسين التهامي وهو يتغنَّى بقصيدة ابن الفارض: التائية الكبرى، فحدث انقلاب في دولة أفكاري». والتهم بعدها المؤلف تراث الصوفية، وتخصص في دراستها، وكان أول كتبه تحقيق «المقدمة في التصوف» لأبي عبد الرحمن السلمي.
أثارت الرواية الفائزة جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية المصرية، منذ طبعها في «دار الشروق» المصرية، حيث اتهم القس عبد المسيح بسيط، أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكلية الإكليركية، زيدان بمحاولة إيحاء القارئ بأن «عزازيل» قصة حقيقية، وجدت في لفائف جلدية أثرية مكتوبة باللغة السريانية، أو الآرامية، وهي لغة المسيح. وقال بسيط، بحسب صحيفة «المصري اليوم» المصرية أثناء الأزمة: «الكاتب بنى روايته على أساس أحداث واقعية وتواريخ معروفة، وقد وضع لها ثلاثة أهداف، هي: الانتصار لمن سمتهم الكنيسة بالهراطقة، وتوجيه هجوم شديد للكنيسة ورمزها القديس مرقس الرسول، إضافة إلى محاولته الإيحاء بأن الله لم يخلق الإنسان، بل إن الإنسان هو الذي خلق الله، وأن فكرة الإله هي من خيال الإنسان».
يتخذ بطل «عزازيل» صورة مغايرة عن تلك النمطية التي نعرفها في الديانات الثلاث الكبرى، وباستثناء بطل الرواية الراهب هيبا، الشخصيات كافة التي تدور حولها الأحداث حقيقية: الأسقف تيودور، الأسقف نسطور، هيباتيا الرياضية النابغة الجميلة التي لقيت مصرعها بالإسكندرية على يد عوام المسيحيين في عام 415 ميلادية وكذلك شخصيات: البابا كيرلس عمود الدين، الأسقف الشاعر ربولا الرهاوى، يوحنا الأنطاكي، وغيرهم.
ينبش زيدان أرضاً جديدة لإخراج بذور العنف وإبطال أصابع الديناميت المدفونة في التراث المصري منذ أكثر من ألفي عام، أما الراهب «هيبا» في الرواية، فهو الإنسان بإيمانه وكفره، وبتناقضاته كافة التي شهد بها تاريخ الإنسانية… قد يعيش في أي زمن، وليس صورة نمطية صنعتها الثقافات لتكرّس مفاهيم أراد لها البعض أن تسود.
الممتع في «عزازيل» أنها جعلت قارئها وكأنه أمام حقيقة مجسدة، من خلال تعايشه مع شخصيات حقيقية كانت من أبطال هذا الصراع القديم والتي اختلفت رؤاهم الفكرية من بينهم: كيرلس أسقف الإسكندرية المُلام الأول في مقتل هيباتيا، نسطور أسقف القسطنطينية والكاهن السكندري وأريوس، اللذان مثّلا وجهة النظر الأخرى عن اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص السيد المسيح.
أكد الناقد مدحت الجيار أحقية فوز زيدان بالجائزة عن رواية «عزازيل»، قائلاً إن للرواية قيمة أدبية لافتة، خصوصاً أن المؤلف عالج في روايته إحدى أبرز القضايا التي يشهدها المجتمع المصري والمتمثلة في الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين من خلال مخطوطة حصل عليها.
أضاف الجيار أن الضجة الإعلامية التي صاحبت الرواية صبت في مصلحة زيدان ومكّنته من اختطاف أنظار النقاد.
أما الكاتب خيري شلبي فشدّد على أن «عزازيل» عمل فني يستحق الفوز، لافتاً الى أن الضجة التي أثيرت حولها ساهمت في تحقيق الفوز. وأشار إلى أن حصول بهاء طاهر على نسخة الجائزة الأولى، وجمال الغيطاني على جائزة دبي يؤكد أن زمن الرواية قادم وبشدة وأن الرواية المصرية لا تزال مترّبعة على عرش الرواية العربية.




