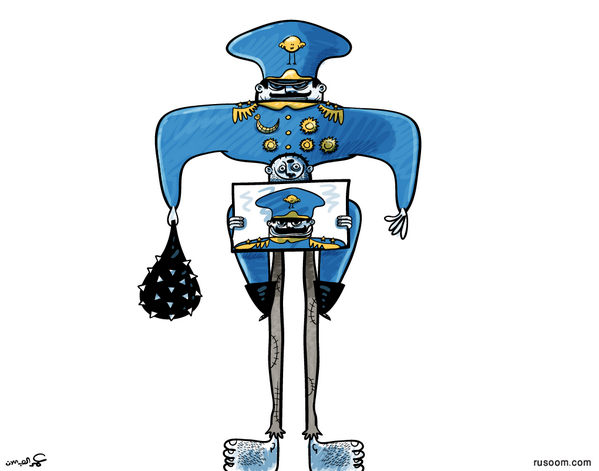ديمقراطية أكثرية، علمانية فوقية، ديمقراطية توافقية؟

ياسين الحاج صالح
من شأن ديمقراطية أكثرية تقوم في سورية أن تكون قناعا لهيمنة الأكثرية المذهبية، السنية. هذا ما يفكر فيه كثيرون منا دون أن يقولونه. يتحدثون بدلا من ذلك عن العلمانية وفصل الدين عن الدولة. لكن فضلا عن أن علمانية فوقية تقتضي دكتاتورية ثقافية وسياسية في بلد لا تشكو الديمقراطية فيه من ازدهارها، فإنها يمكن أن تكون قناعا لهيمنة أقلوية على ما يفكر كثيرون أيضا. وفي النقاش السوري (الملتوي والموارب حيثما وجد) يرفع بعضنا راية الديمقراطية وبعض آخرين راية العلمانية، وتقوم هاتين بدور حجابين يخفيان وراءهما هواجس ومخاوف لها جذور دينية أو مذهبية. فالعلمانية والديمقراطية ليستا، في السياق السوري الراهن، دعوتين فكريتين أو سياسيتين مجردتين، بل هما عنوانين لخيارات سياسية وانحيازات اجتماعية وثقافية، يلعب التمايز الديني والمذهبي دورا جوهريا (وإن لم يكن حصريا) في تحديدها. يُشتبَه على نطاق واسع بأن ديمقراطيين يريدون انتخابات حرة تصعد بفضلها الأكثرية المذهبية أو الدينية إلى السلطة العمومية، وتهمش الجماعات الأقلية. ويُشتبه كذلك بأن علمانيين يلحون على فصل الدين عن الدولة لأنهم ينتمون إلى جماعات دينية ومذهبية أقلية لا فرصة لها لفرض دينها على الدولة، ما يتيح لها تهميش الأكثرية الدينية. ونتحدث عن شبهات لأننا لا نجد نقاشا صريحا ومتحررا ومعافى لهذه القضية. تتملك أكثر المثقفين الرهبة أمام الشحنة التحريمية المزدوجة، السياسية الدينية، التي تحيط بنقاش كهذا. يتوجب أن ننوه إلى أنه لا العلمانية ولا الديمقراطية نشأتا في أوساطنا المعنية بالشأن العام لهاتين الغايتين، وأن ليس كل الديمقراطيين والعلمانيين يستخدمون الديمقراطية والعلمانية أداتيا لتعزيز مواقعهم السياسية وإضعاف خصومهم، مُعرَّفين (هم والخصوم) بهويات دينية ومذهبية. بيد أنه ليس ثمة جدال في أن الاستخدام الأداتي شائع، وهو يكفي كي نسحب الثقة من المفاهيم المستخدمة و”نقيم الحد” عليها (حسب تعبير كان أثيرا لدى المرحوم إلياس مرقص)، لنتبين أنها مفاهيم ملعوب بها من قبل لاعبين اجتماعيين وسياسيين، تلعب بهم هم ذاتهم تناقضات وديناميات لا قبل لهم، على العموم، باستيعابها عقليا والتحكم بها عمليا. يتعين وعي ذلك من أجل تطوير النقاش ورفع حجب التزوير والغش عنه. وفي واقع الأمر، معظم الفاعلين العامين، السياسيين والثقافيين، يدركون الرهانات الخفية وراء الرايتين/الحجابين كليهما، وإن فضل أكثرهم التكتم على ما يختفي تحت رايتهم من رهانات وإبراز المستور تحت راية خصومهم. وهذا مصدر أساسي لفساد النقاش العام وتلوثه بشك الجميع في نيات وخطط الجميع. ** ما ستكون حال الديمقراطية المأمولة في ظل العسر العلماني وضعف ملاءمة ديمقراطية أكثرية في بلد متعدد الأديان والمذاهب والإثنيات؟ ديمقراطية توافقية، تقر بواقع التعدد الطائفي وتتخذ القرارات الأساسية فيها بالتوافق لا بالأكثرية؟ هذه تجنح، كما يظهر المثال اللبناني، إلى تثبيت الانقسامات الطائفية. وهي لا تبدو، في المثال ذاته، مرحلة على طريق إفقاد الانقسامات تلك “قيمتها التبادلية” السياسية، وتاليا نحو قيام ديمقراطية أكثرية، تتمايز فيها الأكثريات والأقليات على أسس سياسية متبدلة. إلى ذلك فإن الديمقراطية التوافقية مقترنة بضعف الدولة، وهذا أمر يمكن تحمله في سويسرا وبلجيكا الأوربيتين (الأولى هي المثال الكلاسيكي للديمقراطية التوافقية)، لكن التساهل بشأنه في لبنان وسوريا الشرق أوسطيين (حيث الأوضاع الإقليمية متقلبة ومجبولة بالعنف والسيطرة، والعلاقات بين الجماعات الأهلية ليست مثالا للمودة، والفرد ضعيف) قد يحمل في طياته مخاطر تفجر حروب أهلية دورية. وعلى أية حال، يبدو لنا أن الإسلاميون هم من يميل اليوم إلى تنويعة من الديمقراطية التوافقية (في الثقافة السياسية السورية، التي تعلي من شأن الاندماج وتغض من شأن التعدد المحلي ثمة ميل مهيمن إلى التركيز على أطرافها الطائفية الفاعلة لا على الآليات التوافقية لاتخاذ القرار فيها، لذلك تنعت بأنها ديمقراطية طائفية). ونقدر أن وراء ذلك أسبابا ثلاث: أولها، لأنهم يقدرون أن موقع السيطرة السياسية في نموذج كهذا سيكون لهم بسبب التكوين الديمغرافي للمجتمع السوري؛ ثانيها، لأنهم يميلون تلقائيا إلى التفكير في المجتمع كمتحد ديانات وعقائد، أو “ملل ونحل”، ويجنحون إلى التصرف كطائفة رغم انتسابهم للأكثرية المذهبية، وذلك بسبب ضعف علاقتهم بالحداثة وخوفهم منها (لا تتكون هيمنة، وتاليا أكثرية مهيمنة، على غير أرضية الحداثة، لذلك الإسلاميون لا يمكن أن يحتلوا موقعا هيمنيا في الاجتماع السياسي السوري)؛ ويتصل بذلك سبب ثالث: كون نظام الديمقراطية التوافقية قريب من الثقافة السياسية الإسلامية، ويذكر بنظام الملل. على أن السبب الذي قد يجتذب الإسلاميين إلى هذا النموذج، أعني وجود أكثرية مطلقة مسلمة سنية، هو ذاته ما قد يثير حياله شبهات تماثل تلك التي تلابس نموذج الديمقراطية الأكثرية في أوساط متحدرة من جماعات دينية ومذهبية أقلية. والحال إن من وجوه فرادة الحالة السورية تواجد أكثرية مطلقة وأقليات وازنة تشكل ما قد ينوف على 40% من السكان في الوقت نفسه. إلى ذلك فإن نسبة العلمانيين من أصول سنية سوسيولوجيا ليست هينة (هي منذ اليوم عنصر كسر مهم للاستقطاب المذهبي والديني)، وهؤلاء ميالون إلى التشكك في نموذج ديمقراطية توافقية لأنه يهمشهم نهائيا وقد يحكم عليهم بالالتحاق بنوع من بيت الطاعة الطائفي. ** هل من مخرج من هذه المعضلة؟ سنلاحظ بداية أن وجود المعضلة ونقص جاذبية المخارج المتصورة لها هو من أكبر العوائق في وجه التغيير السياسي في البلاد. في مثل هذا الشرط يتمتع الوضع الراهن بما يشبه “حق الشفعة”، أي أفضلية الاستمرار لغياب بدائل منافسة متمتعة بالصدقية. فهو يقيد تناقضات اجتماعية وسياسية، حلها غير ميسور، ومن شأن انفلاتها أن يثير تفاعلات انفجارية متسلسلة لا تسهل السيطرة عليها. وسنلاحظ، ثانيا، أن الديناميات الإقليمية تدعم حق الشفعة هذا، بقدر ما هي ترفع من قيمة الاستقرار في مواجهة أوضاع متفلتة ومخيفة. نقطة الضعف الأكبر في الأوضاع القائمة هي أنها غير قابلة لحياة مستدامة لاتسامها بتفاوتات هائلة وحرمانات فاقعة، فضلا عن افتقارها إلى آليات تصحيح ذاتية تحد من أسوأ آثار تلك التفاوتات والحرمانات. فاستمرار القائم ينبع من قتامة آفاق تغيره لا من قدرته على اجتراح حلول فعالة للمشكلات الاجتماعية والوطنية. هذا وجه أساسي للاستعصاء السوري. لا مجال للقفز فوق المعضلة. القول، تهويناً، إن تسعين بالمئة من السوريين عرب (قرابة 10% أكراد ومجموعات إثنية صغيرة) وتسعين بالمائة مسلمون (حول 10% مسيحيون ومجموعات غير مسلمة ضئيلة)، وهو قول الإخوان المسلمين السوريين، لا يعدو كونه مخرجا لفظيا من مشكلة واقعية. فالملاحظة العيانية تشير إلى أن الاشتراك في العروبة والإسلام لا يسم العلاقات بين المسلمين الشيعة والسنة في العراق بالتراحم والأخوة. والشراكة الإسلامية مع الأكراد لم تمنع في الماضي معاناتهم من حرمانات سياسية وحقوقية شديدة، وصلت مرتبة جرائم ضد الإنسانية في “أنفال” صدام حسين، ولا التباعد السياسي والنفسي بين الوسطين العربي والكردي اليوم. ليس غرضنا، ولا في مستطاعنا، تلفيق إكسير متعجل لمشكلات معقدة. حسبنا إثارة اهتمام القطاع الناشط (الضئيل) من المشتغلين بالشأن العام بها، والتنبيه إلى التحايل والاستغفال المتبادل الذي يكتنف صيغ النقاش القائمة. ولا نتخيل تخلق حل أصيل في وقت قريب. نرجح أن عقودا ستنقضي قبل أن ترسو النظم السياسية في المنطقة على أسس صالحة وذاتية الإصلاح. ومعلوم أن الأوضاع الراهنة ذاتها في المشرق العربي نتاج عقود من تحطيم نخب حكم متدنية المستوى للحياة السياسية في بلدانها، ومن تحطيم المحور الأميركي الإسرائيلي لمعنوياتها وسد آفاقها. قبل ذلك لم تكن الأحوال سمنا على عسل، لكنها بالتأكيد لم تكن بارودا على دم.
المقالة منشورة في خريف 2006