مئوية جان جينيه
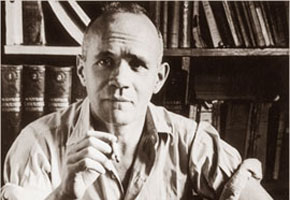
مئوية جان جينيه: الكـذاب الرائـع
عبد الرحيم الخصار
خلال هذا الشهر تحتفل الأوساط الفرنسية بمئوية جان جينيه، أحد أكثر الكتاب حضوراً، ليس في فرنسا فحسب، بل في العالم، السجين واللص الذي قال عنه جان كوكتو «إنه أكبر كتّاب عصره»، وخصص له جان بول سارتر كتاباً من ستمئة صفحة بعنوان «القديس جان جينيه»، حوّل المقصي والمرفوض والملغى والمترفع عنه إلى أدب كبير، وتحوّل هو نفسه من لقيط ومتشرد إلى إحدى ظواهر الأدب الفرنسي في القرن الماضي.
ولد جان جينيه في 19 كانون الأول (ديسمبر) من عام 1910، وتكريماً لذكراه تقوم دار غاليمار بإعادة طبع وتوزيع مجموعة من أعماله الشهيرة، من بينها كتاب «البهلوان» الذي خصصه لصديقه عبد الله لاعب السيرك، كما ستصدر لأول مرة مراسلاته غير المنشورة، إضافة إلى مجموعة من الكتب ألفها عنه كتّاب آخرون، مثل «جان جينيه رقم قيد 192.102» لباسكال فوشي وألبرت ديشي، ويسردان من خلاله تجربة الكاتب في مرحلة التطوع العسكري، و«جان جينيه، الكاذب الرائع» للطاهر بنجلون الذي جمعته به آصرة الصداقة خلال السبعينيات، ويستعيد بنجلون تجربة الشاعر في العمل السياسي وعلاقته بالفهود السود والألوية الحمراء، ودفاعه عن الفلسطينيين. كما تعيد دار غاليمار نشر كتاب سارتر «القديس جان جينيه، الممثل و الشهيد» الذي صدر أول مرة سنة 1952.
أما دار دينوي فتنشر كتاباً جديداً بعنوان «انتحار جان جينيه»، ويقف فيه مؤلفه على تفاصيل محاولة انتحار الكاتب سنة 1967.
وسيعرف الوسط الأدبي الفرنسي مجموعة من اللقاءات الثقافية والأمسيات القرائية خلال الأسبوع الحالي والأسابيع المقبلة احتفاءً بكاتبها المثير للجدل، والمستفز ليس في أعماله الروائية والمسرحية فحسب، بل في حواراته أيضاً وفي مكاتباته الخاصة لأصدقائه: وعلى الأخص منهم سارتر وسيمون دي بوفوار وجان كوكتو وفيوليت ليدو.
والغريب أن فرنسا التي تحتفل بجان جينيه اليوم، والتي احتفلت بطريقة خاصة قبل سنوات بالذكرى العشرين لوفاته، هي فرنسا التي عاش جان جينيه يتبرأ منها، ويعتبر أن الخيط الوحيد الدقيق الذي يجمعه بها هو خيط اللغة.
طفل خارج القانون
حين سئل جينيه عن بدايته الأدبية، وعن المكان الذي تعلم فيه الكتابة لم يتردد في ذكر إصلاحية «ميتراي»، التي قضى فيها جزءاً من حياته كطفل خارج عن القانون، فهناك عثر بالصدفة على ديوان الشاعر الفرنسي بيير دو رونزار (1524-1585) فكان أول منارة تستدرجه إلى ميناء الأدب. وسيتحدث عن «ميتراي» وعن الأسباب التي قادته إليها، وعن طبيعة الحياة القاسية التي عاشها هناك من خلال عدد من الأعمال السردية، سيما «يوميات لص» و«معجزة الوردة».
فالطفل الذي كان مجهول الأب، والذي تخلّت عنه أمه غابرييلا جينيه بعد أشهر من ولادته سيجد نفسه في ملجأ للأيتام ومن ثم إلى أحضان أسرة ريفية، وحين سيبلغ عامه الرابع عشر سيتحوّل إلى مشاغب ومتمرد يصعب ضبطه، وسيلقى عليه القبض ليعهد به إلى إصلاحية ميتراي، وكي يتخلص من جحيم الحياة هناك تطوع قبل الوقت في الخدمة العسكرية لمدة سنتين. وفي عامه العشرين سيذهب إلى سوريا للمساهمة في بناء قلعة عسكرية، وسيتطوع مرة أخرى للعمل في الجيش الفرنسي داخل المغرب، ثم سيهرب من الجندية ليواصل تسكعه عبر العالم.
غير أنه سيعود نهاية الثلاثينيات إلى باريس ليتحول إلى لص يسرق بعض الأشياء التي لا يسرقها أحد، فعدد من مسروقاته كان عبارة عن كتب، ثم إن حياته القاسية كمتشرد وكمنبوذ ستكون سبباً في دخوله إلى عالم الجريمة، لذلك سيزج به في السجن لتكون تلك هي فرصته للكتابة، وهناك سيبدع عمله الروائي المدهش «سيدتنا ذات الأزهار»، إضافة إلى نصه الشعري الطويل «الرجل الذي حكم بالإعدام».
وتبقى كلمة «لقيط» إحدى أكثر الكلمات تأثيراً على الحياة الأدبية لجينيه، فثمة رغبة دائمة في الانتقام من شيء ما، تستعاد باستمرار كلما تعرض للإهانة، وكلما تذكر ما كان يقع له في طفولته بسبب هذا القدر الذي لم تكن له يد فيه، ففي سنواته التعليمية الأولى كتب أحسن نص في الفصل يصف البيت الذي يعيش فيه، وقد أشاد مدرّسه بالنص واحتفى به، غير أن الأطفال سيهزؤون منه مؤكدين للمعلّم أن البيت الذي يصفه ليس بيته، لأنه أصلا لقيط. وسيفضل حينها أن يغادر الفصل وهو في الثالثة عشرة ليعيش متشرداً بدل أن يبقى تلميذاً متفوقاً في مدرسة لا تجد حرجاً في جرح مشاعره، هو الذي قال «ما من مصدر آخر للجمال غير تلك الجراح المتفردة، المختلفة بالنسبة لكل واحد، المخفية أو الظاهرة التي يكنها كل إنسان في نفسه ويحفظها في داخله ويرتد إليها حينما يريد مغادرة العالم الى عزلة موقتة وعميقة»، وبالفعل استطاع صاحب «معجزة الوردة» أن يحول جراحه إلى جمال فريد، تجلى في معظم أعماله الأدبية التي نالت نصيباً واسعاً من الشهرة.
بين طنجة وشاتيلا
كان جان جينيه يعشق طنجة ويعتبرها المدينة التي يمكن أن يجد فيها الكاتب ذاته، وكان يظهر هذا العشق ويضمره، وفق مزاجه طبعاً، لكنه لم يكن يشكو من التحولات الطبيعية التي تطرأ على المدينة كما كان يفعل الأميركي بول بولز مثلا، فصاحب «السماء الواقية» كان يريد طنجة التي رسمها في خياله، بينما كان جينيه يريد طنجة كما هي بجميلها ونقيضه، بسحرها وبفوضاها أيضاً. ولم يكن هناك كاتب عالمي يصل إلى طنجة دون أن يبحث عن جينيه الذي صار واحداً من أساطير المدينة. وفي كتاب شيق ألفه محمد شكري بعنوان «جان جينيه في طنجة» يسرد تفاصيل الوقائع التي ربطته بالكاتب خلال إقامته في فنادق المدينة وخلال تسكعه في شوارعها وحاناتها.
عرف عنه كرمه وطرافته وحبه للمتشردين والفقراء ومعاشرته للبسطاء بالرغم مما كان يغلف حياته المغربية من عزلة، تجوّل جان جينيه كثيراً وعاش في العديد من البلدان، لكنه أحبّ المغرب بشكل خاص جداً وفريد، وما من دليل على ذلك أوضح من تمنيه الموت في طنجة، مات بعيداً عنها في باريس ولكنه أوصى في أيامه الأخيرة بأن يدفن على مقربة منها، إذ لا يزال قبره في مدينة العرائش شاهداً كبيراً على ذلك.
ويبقى كتابه «أربع ساعات في شاتيلا» أقرب مؤلفاته إلى ذاكرة القارئ العربي، فقد عاش أشهراً مع اللاجئين الفلسطينيين، وكان أول أجنبي يصل المخيم مباشرة بعد تعرض سكانه للتقتيل، يقول في هذا الكتاب واصفاً تلك الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق اللاجئين: «إن قاتلين قد أنجزوا العملية لكن جماعات عديدة من فرق التعذيب هي في غالب الظن التي كانت تفتح الجماجم وتشرّح الأفخاذ، وتبتر الأذرع والأيدي والأصابع وهي التي كانت تجر بواسطة حبال محتضرين معوقين رجالاً ونساءً كانوا لايزالون على قيد الحياة».
(الرباط)
السفير
في الذكرى المئوية لميلاده: جان جينيه، الجندي العاشق
د. عائشة البصري
مضت مائة عام على ميلاد الأديب الفرنسي جان جينيه في باريس ومضى زهاء ربع قرن على مقامه بيننا في مقبرة متواضعة تطل على زرقة المحيط الأطلسي وصخبه من أعلى ربوة هادئة بمدينة العرائش المغربية. للتمعن في سر العشق الذي دفع بالكاتب إلى هاته الهجرة العكسية التي أقصى من خلالها ذاته من الغرب والشمال ليهبها إلى الشرق والجنوب معا ، لا بد من الوقوف على ماضي جينيه الجندي الذي جعله يتعرف على العرب لأول مرة ليحبهم ثم يتمادى في غضبه ونقمته على الغرب.
ولد جينيه في التاسع عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 1910 من أب مجهول وأم تخلت عنه بعد مضي بضعة أشهر على ولادته ليصبح تحت وصاية المؤسسة العامة لرعاية اللقطاء التي عهدت به بدورها الى أسرة في إحدى قرى منطقة المورفان الفرنسية ليتربى في ظلها حتى يبلغ الثالثة عشرة من عمره. وما أن أُجبر على ترك هذه الأسرة التي أحبته وأحسنت إليه إلا أن تحول الفتى جينيه الى متمرد وثائر وغاضب على جميع أعراف وأخلاقيات المجتمع ومؤسساته الحكومية التي لاحقته وحاكمته باستمرار. هكذا دخل جينيه حلقة التشرد والتوقيفات والإحتجازات التي انتهت به في مؤسسات العقاب بما فيها سجن القاصرين الذي كان يعرف بالإصلاحية الزراعية والذي سيقبع فيه الشاب منذ الخامسة عشرة من عمره الى أن يبلغ التاسعة عشرة حين التحق بالجيش الفرنسي.
جينيه جندي في أرض العرب
من أجل الخروج من سجن القاصرين قبل سن الحادية والعشرين، إرتأى جينيه أن يستبق استدعاءه للخدمة العسكرية في آذار/ مارس 1929. إذ تطوع في الجيش لمدة سنتين في صفوف الفيلق الأجنبي الذي كان يتكون من فرنسيين وأجانب في خدمة حملات فرنسا الإستعمارية. لم يكن دافع جينيه نزعته الوطنية بقدر ما دفع به اليأس والعوز للإرتماء في حضن جيش ووطن سيمقتهما لاحقا.
حط الجندي جينيه الرحال بدمشق في كانون الثاني/ يناير 1930 إبان الاستعمار الفرنسي لسورية وسرعان ما اختلط عليه حقده على فرنسا بميوله نحو ضحاياها. في حديث له مع الصحافي الفرنسي بيرتران بوارو ديلبش في كانون الثاني/ يناير 1982 وصف جينيه الشعور المُربك الذي انتابه حينذاك ودفع به لخيانة فرنسا من أجل كسب حب العرب قائلا: ‘لقد كان شباب دمشق يستمتعون كثيرا بإطلاعي على الدمار الذي ألحقته بالمدينة مدافع الجنرال غورو. إذ صارت لدي رؤية مزدوجة للبطل والشخص الحقير والمقيت في نفس الوقت الذي كان يمثله غورو. هكذا سرعان ما أحسست بوقوفي الطبيعي إلى جانب السوريين. ربما كان هذا الإحساس في البداية يتسم بشيء من المَكر لكوني كنت أرغب أن ينظروا إلي نظرة حسنة، وأن يحبوني وأن يسمحوا لي بأن أشاركهم لعبة الورق’.
تجددت تجربة حبه للرجل العربي الممزوج بالمَكر والشعور بالذنب بتجديد الجندي جينيه لتطوعه في صفوف الجيش الفرنسي. ففي حزيران/ يونيو 1931 عاد جينيه ليتطوع من جديد في صفوف فوج المشاة المغاربة وهي وحدة من جيش فرنسا كان مقرها في مكناس. هكذا كان أول لقاء لجينيه مع المغرب والمغاربة كجندي محب مذنب خجول قضى تسعة شهور ما بين مدينتي ميدلت ومكناس قبل أن يتطوع مجددا في صفوف فرقة مشاة جزائرية مقرها بمدينة تول الفرنسية، ثم فرقة جند المشاة الكولونيالية بإيكس سان بروفانس. لكن يبدو أن تطوعه لخدمة فرنسا بعيدا عن مستعمراتها لم يرق لجينيه الذي قرر أن يهرب من الجندية في حزيران/ يونيو 1936 ليسدل الستار على مرحلة العسكرية التي دامت زهاء ست سنوات. فضل جنية إلتزام الصمت عن ماضي الجندية بل إنه اختزله في ‘بضعة شهور’ في كتابه ‘مذكرات لص’ الذي يروي فيه ابن فرنسا الشقي سيرته الذاتية كما تـُروى أساطير الإلياذه والأوديسة. يقول:
‘إن الشعور بالكرامة الذي يمنحه الزي العسكري للفرد، والعزلة عن العالم التي يفرضهاهذا الزي بالإضافة الى مهنة الجندي نفسها، وهبتني قسطا من الراحة والثقة بالنفس حتى ولو أن الجيش يوجد على هامش المجتمع-. مما خفف من وضعي كطفل تم إذلاله بشكل طبيعي. هكذا استمتعت برفق استضافة الرجال لي’.
لا شك أن جينيه يقلل هنا من شأن ماضي الجندية الذي يتناقض مبدئيا مع صورة الكاتب الهامشي التي رسمها لنفسه، ليفسح مجالا أكبر لكل ما يغذي ويخدم أسطورة اللقيط، اللص، السجين، المِثلي، المناهض للإستعمار والمناصر للمستضعفين. ربما حاول جينيه أن يتحاشى أن يذكره البعض بأنه قبل أن يثور على فرنسية فرنسا فإنه كان جزءا من آلتها الإستعمارية وإن كان ذلك على مضض وأن يذكره آخرون بأنه ربما كان قد خان العرب قبل أن يصاحبهم. لكن مثل هذه الإتهامات قد تبطلها فلسفة الأديب نفسها التي تمجد الخيانة كفضيلة مقدسة بل تحتفي بازدواجية الخيانة التي طبعت علاقته بالعرب والغرب في آن واحد. فإن كان الكاتب قد خان العرب بخدمته لفرنسا الإستعمارية فانه قد خان هاته الأخيرة أيضا بمناصرته لشعوب مستعمراتها وبحبه للرجل العربي على وجه الخصوص.
فعلى كل من يعشق جان جينيه أن يدرك بأنه ليس للوفاء والإخلاص وغيرهما من القيم المعتادة مكانة في كتاباته التي تنبذ القيم التي يصفها جينيه بالبورجوازية ليستبدلها بالخيانة والسرقة والحب المثلي في العالم الهامشي الشهواني المنشق الذي نصبه لقرائه؛ عالم يصعب فيه فصل مساندة جينيه للقضية الفلسطينية والمقاومة الجزائرية وحقوق المهاجرين المغاربيين عن نظرته العاشقة والمِثلية للعالم. ففي مقابلة له مع هوبرت فيشت في العام 1976 أفصح جينيه عن مدى تداخل مواقفه السياسية وميوله الجنسية: ‘كنت ربما سأقف معهم (الجزائريين) في كافة الأحوال غير أنه ربما مِثليتي هي التي جعلتني أرى أن الجزائريين ليسوا مختلفين عن باقي الرجال’.
لقد كان للإيروسية (الشهوانية) العربية التي ألهمت أندريه جيد وغيره من الأدباء الغربيين وقع خاص على جينيه لدرجة جعلت الحب والأدب والسياسة تمتزج عنده امتزاج العاطفة والجسد بالفكر. فليس من الغريب في شيء أن تكون علاقته بعبد الله بن تاكا الشاب الألماني من أصل جزائري الراقص على الحبال قد ألهمته كتاب ‘الراقص على الحبال’ الذي يعد من أعمق ما كتب عن جمالية الرقص، فكان لانتحار عبد الله في ربيع 1964 أثر بليغ على الكاتب الذي أحرق مخطوطاته قبل أن يحاول الإنتحار بدوره.
مع الفدائيين الفلسطينيين
فقد جينيه رغبته وقدرته على الكتابة إثر هذا الحادث المأساوي ولم يعرف للكتابة والحياة معا طعما إلا بعد لقائه بالفلسطينيين في أوائل السبعينات وزيارته للفدائيين والعيش في مخيماتهم ومعاينة مجزرة صبرا وشاتيلا التي دونها بطريقته في ‘أربع ساعات في شاتيلا’ ، كما روى عشقه للفلسطينيين من خلال ‘الأسير العاشق’ آخر كتاب له يتداخل فيه التاريخ والشعر والسياسة.
لا شك أن مناصرة جينيه للقضية الفلسطينية تدخل في اطار رفض الهامش للمركزية الغربية التي عاقبته بينما تدعي الحرية وآلة الحرب العالمية التي تساند العدوان بينما تدعي السلام. لكن هذه الإعتبارات لا تنفي الجانب الإيروسي الذي جعله يقدم حبه للفلسطينيين على شرعية القضية بعينها :’الحق كل الحق مع الفلسطينيين لأني أحبهم’ يقول جينيه. كما يضيف قائلا في أربع ساعات في صبرا وشاتيلا :’إن الوضوح البديهي العجيب لما حدث، وقوة تلك السعادة المرافقة لوجودهم (الفلسطينيين)، يسميان أيضاً: الجمال’. وعن جمال الفلسطينيين و’شهوانية’ الثورة الفلسطينية تحدث جينيه بإسهاب بشكل أدهش بل أحرج أكثر من قارئ:
‘إن التأكيد على وجود جمالٍ خاص بالثوريين يطرح صعوبات كثيرة. من المعلوم ـ بل من المفترض ـ ان الأولاد الصغار، أو المراهقين، يعيشون في أوساط عتيقة قاسية، ولهم جمال في الوجه والجسد والحركة والنظرات، يقرب كثيراً من جمال الفدائيين (…) كانت قد ترسبت كل الحساسية الشهوانية التي حررتها الثورة والبنادق. علينا ألا ننسى البنادق. فقد كانت كافية، وكل واحد كان مفعما بالرغبات. (ترجمة من كتاب ‘أربع ساعات في صبرا وشاتيلا’ نُشرت في مجلة ‘الكرمل’، العدد السابع، 1983)
الحقيقة أنه حين يتعلق الأمر بجان جينيه يستحيل اختزال علاقته بالفلسطينيين في القضية نفسها ـ بغض النظر عن إيمانه بصوابها ـ بل يجب الأخذ بعين الإعتبار بقيمه الأخرى مثل الجمال والموت والعنف والعزلة: ‘هل كنت لأحب الفلسطينيين لو لم يجعل منهم الظلم شعبا مشردا؟’ يتساءل جينيه الذي طالما ردد ‘ أنا مع كل انسان وحيد’، ‘أحب من أحب وهم دائما أشخاص جميلون وأحيانا مضطهدون لكنهم صامدون في ثأرهم’. حسب منطق جينيه، يحق لنا أن نتساءل بدورنا: هل كان لجينيه أن يحب المغرب الى اللحد لولا تعلقه بتشرد وفقر محمد القطراني ذلك الشاب العرائشي الذي ُيحكى أن الكاتب كان قد عثر عليه مستلقيا على الأرض نائما في أحد أزقة المدينة القديمة في طنجة؟ ألم يجد الكاتب نفسه منجذبا إلى هذا الشاب الفقير الذي فر من الجندية لأنه ربما ذكره بجينيه الجندي الهارب اللص الشريد؟
‘لم يكن محمد القطراني مثليا جنسيا، غير أن جينيه أفهمني مرارا وتكرارا بأنه لم يكن يمارس الجنس مع هذا الشاب. أقدم على تزويجه من امرأة كانت جارة لأسرته وأنجب منها طفلا سارع جينيه إلى تسميته بعز الدين وهو الإسم الشخصي لممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس ‘عز الدين القلق’ الذي اغتالته المخابرات العراقية عام 1978′. يقول الطاهر بن جلون في أحد مقالاته موضحا، بل معقدا علاقة جينيه بالعرب التي قد يرى فيها البعض شيئا من الإحراج بيد أن كاتب ‘يوميات لص’ لا يرى فيها إلا مزيدا من الحرية: ‘كلما كبر ذنبي في عيونكم، أفترض أن تكون حريتي أكبر’ يقول جينيه الذي يحبه كل من يضع الحرية فوق كل اعتبار.
كاتبة مغربية
القدس العربي
جان جُنيــه هــل هــو كاتــب فحســب؟!
اللَّفَْتََةُ التي تُحََطِّم القانونََ لها سلطانُ الكتابة
جان جُنيه
ترجمة لمقالة فرنسية قام بها «غـــازي أبو عـــاقل»
هنالك كلمة واحدة يُسَمَّى بها جُنيه هي: كاتب. قبل كونه شخصية توالى عليها الشقاء والتَّعاسة، وبطل مسلسل لا ينفد من سِيَر الحياة المختلفة، فإن جنيه هو كاتب.
قال فاليري بكثير من بعد النظر «ينتهي كل شيء في فرنسا بالسوربون». واليوم ينهض تمثال فاليري في هذه الجامعة وبجواره، إلى الأبد، رفيق قديم هو الشاب «الأزعر» الذي تَلَقَّى جان كوكتو ذات يوم من فاليري نفسه نصيحة بإحراق كتبه.
مَن كان كاتباً أكثر منه؟ الموهوب البارع الذي لا يُضاهى في صياغة الجملة والإيقاع، العارف إلى أطراف أنامله، بالتجربة، ما الذي ينبغي فعله، لم يَدَع شيئاً لم يقرأه ولم يتعلمه ولم يفهمه، مُعَلّمٌ في فن ذر الرماد في العيون والتألق والإبهار، خبير مجرَّب في البلاغة، حاملٌ «الجائزة الكبرى» في الآداب والفنون. كاتب بكل تأكيد. شريطة أن نضيف مع ذلك، أنه إذا كان كاتباً أكثر من أي كان، فإنه كان ـ كاتباً ـ أقل من أي شخص آخر. ولئن كان ـ في آن معاً ـ كاتباً ونقيض كاتب، خدمَ الأدبَ بمقدار ما استخدَمَه، فلن يكون بوسعنا، ولن نعرف وضعَه في الطائفة الأدبية التي ينتمي إليها، دون أن نفقد في اللحظة نفسها، فَرادَتَهُ الجوهرية الأصيلة التي تجعل منه شاعراً بحق، شاعراً بالتعريف غير «الرشيد» الذي يعطيه للشعر، عندما يقول متناسياً تهذيبه المعتاد: «الشعر، هو فن استعمال الغائط وجعلكم تأكلونه».
يسبقُ الكاتبَ في إهابه، رجلٌ في حالة حرب، والبقية تتبع. يُطيع الخطةَ الموضوعة، وينخرط في لعبة ذاك الذي فَهِمَ، منذ البدء، أن الكتاب هو السلاح العظيم، السلاح المطلَق.
قد لا تكون أعمال جنيه كلها، إلا إعلان حربٍ مديدة ومتطاوِلة. الجملةُ الأولى في كتابه الأول «سيدتنا عذراء الزهور» تبدأ فوراً كما نطلق رصاصة تدل إلى العدو، تُسدد إليه بإلحاح قاهر: «بدا لكم وايدمان في طبعة الصحيفة الصادرة في الساعة الخامسة، ورأسه ملفوف بضمادات بيضاء كأنه راهبة، أو كطيار جريح سقط في حقل من الشيلم ذات يوم من أيام أيلول»..
سنفهم سريعاً أن العدو ليس وايدمان، هذا «القاتل الساحر المغري» قاتل النساء الستّ الذي أعدم بالمقصلة في باريس سنة 1939. وايدمان هو الأيقونة ـ ليس إلا ـ الذي وضعَ جُنيه كتابَه برعايته كما لو أنه يضعه برعاية أحد القديسين.
العدو الحقيقي هو الذي يُنتَزَع من مكمنه، بكلمة كأنها إصبع الاتهام التي تثقب العرف الروائي: هذه «الـ أنتُم» النافرة ,المخالِفة, التي أراد مصححُ طبعة الكتاب الأولى وضعَ كلمة «نحن» الأكثَر مؤانسة في مكانها. إلى مَن تَتوجَّه هذه الـ أنتم إذاً؟ إليكم وإليّ، إلى الناس جميعاً، إلى المجتمع بكامله، وقبل كل شيء إلى القارئ. وفي الوقت نفسه الذي يُنَبّه فيه جُنيه تواطؤَ القارئ معه، فإنه يخون هذا التواطؤ فوراً. وبين الكتاب والقاريء يَمُر خطُّ إطلاق النار.
هكذا ينتصب المسرحُ الأولَ البَدْئي، المسرحُ الكبير الخيالي لصانعه جان جْنيه. يتواجه هنا طرفان، مُعَسكران: الدنيا من طرف، وهو من طرف ثانٍ. وينطلق الأمر كله من هناك. من الزنزانة المنفردة [LA cellule – هنالك كثيرون يسمونها بالعربية السَلُّول..
لا تُشكّل «المنفردةُ»، حيث يدَوّن جنيه كتابتَه الأولى، بهذا المعنى إطاراً أو مجرد بيئة ظَرفية: إنها تُعطي لنِتاجه بأكمله المكانَ الرئيس لعَرضه وإيضاحه. ليس المهم أن يكون مُعتَقلاً أولا: ذلك أن جنيه يوجه دائماً خطابه إلى قارئه من الجانب الآخر للجدار. وهذه المسافة ليست غير مقصودة أو طارئة، ولا موقتة عابرة: إنها المدى الذي ينمو فيه خطابه ويتطَوّر كلامه، وهي الهواء الضروري لتنفسه، وهي مكمن الرامي وابتعاده في المكان والزمان لتأمل حدَثٍ ما والحكم عليه. تشبه هذه المسافة تلكَ التي تفرضها تماثيل [النحّات جياكوميتّي المرتفعة، هي أسلوب هذا العمل وأناقته وتهذيبه.
ها هي الحدود قد رُسمتْ والأدوار قد وُزّعت، ونص مسرحية الحرب جاهز، هذه الحرب التي ستدور رحاها على أرض اللغة طوال أربعين سنة دون ضعفٍ ولا كلل، مُستَعملةً وسائل الفن العسكري وحِيَله وموارده: أفخاخه وخِدَعه، تمويهه وتظاهراته المُتَصَنَّعة، انقضاضاته وانسحاباته، مكائده وتَسَلّله، تَحالَفاته وخياناته.
نُظّمت حربُ جان جنيه على غرار سلسلة من العمليات ذات الخطط البعيدة المدى. مُقلِقةً أبهاء بيت الأدب وعابرةً ردهاته المتنوعة، من شِعر ورواية ومسرح ورقص ومقالة ومذكرّات. ولسوف تدور هذه الحرب الشاملة تبعاً لأنماط ثلاثة.
النَّمط الأول ـ الرواية: عملية جبهية
يمتد أول أنماط كتابة جُنيه، وهو الأكثر سطوعاً وصخباً بلا ريب، من «المحكوم بالإعدام» إلى «يوميات اللص». هذه الأعمال التي تشير إلى دخول مرتكب الجنح إلى منصة المسرح الأدبي. دخولٌ بالخَلعْ والكَسْر بكل تأكيد. هجومٌ بارعٌ عالِمٌ ثاقب، مُلَبَّد صامت، مُزَخرفٌ تارة، فظٌ شرسُ تارة أخرى، لكنه هجوم جبهي من ناحية المبدأ ومن ناحية العَرْض: يضع هذا الهجوم، كما قلنا للتوّ، وجهاً لوجه أنا جان جُنيه، المؤلف والشخصية المتفردة، وأنتم القراء، البشر الأحرار، قوم الطرف الآخر.
يقود جُنيه هذا الهجوم باسمه الصريح، وباسم الذين يدعوهم «سجناء الأشغال الشاقة»، الذين يَعُدُّ نفسَه من فصيلتهم، من اللصوص والمخَنَّثين والداعرين والقتلة والميليشياويين والمهربين – وغيرهم من الخونة والمسوخ المخيفين، الذين يعيشون «في قفا الدنيا»، هؤلاء جميعاً تُعيدُهم مؤلفات جُنيه بالتحايل والغش وبكثير من الروعة والعظمة، في آنٍ معاً، إلى مسرح الأدب.
تنتهي هذه الحقبة في سنة 1949 تقريباً، وفيها نفسها حصَل جان جُنيه من رئيس الجمهورية الفرنسية يومئذ فنسان أوريول، على عفوٍ عن السنين التي كانت باقية والتي كان عليه قضاؤها في السجن. وهي أيضاً الحقبة التي بدأ فيها نِتاجه يفيد من بداية اعترافٍ أدبي. هكذا جاءت بشكلٍ ما هذه الفاجعة المزدَوَجة، النجاح والعفو، التي ستقود جُنيه إلى اكتئاب نفسي، جعله وهو يناهز الأربعين يفكْر بالانتحار مدفوعاً – كما قال – «بسأم من العَيش وفراغ داخلي ليس بوسع أي شيء إنهاؤهما إلا الانزلاق النهائي». ذلك أن عنف كتابة جُنيه كان على سوية الخطر الذي تَعرَّض له وتَحَمَّله.
كانت جدران السجن، التي كُتبت مؤلفاته بينها، بطريقة ما هي الضمان الغريب لحريته. ولسوف يقول جُنيه في لقاء إعلامي جرى بعد زمن طويل: «ما إن أصبحتُ حراً حتى شعرت بأني ضائع».
ضائع؟ هذا يعني أنه يخالط الدنيا، مجرداً مخلوعاً من اللعنة، مُستَثنى من الاستبعاد منبوذاً من النَّبذ، ضئيلاً إلى درجة أنه لم يَعد إلا كاتباً، فناناً بين آخرين كثيرين… توجد طريقة لخسارة الحرب تقوم على كَسْبِها.
المسرح، المناورة المائلة
صَرفَ جُنيه ستَ سنوات للإفلات من شَرَك نجاحه، والعثور على مخرج من المأزق الذي أغلقه على نفسه. زَوَّدَهُ المسرحُ أولاً بهذا المخرج. ففي تلك المرحلة كان جُنيه قد كتب عدداً من المسرحيات (رقابة مُشَدَّدة ـ الخادمتان ـ SPLENDID`S) بالإضافة إلى مسرحيتين أو ثلاث مفقودة. لكنه ما كان قد استثمر بمنهجية موارد فن الكتابة الدرامية التي تَعامَل معها بحَدْسِه يومئذ.
اكتشف جنيه مع مسرحية الشرفة LE BALCON، التي باشرها في 1954، زاوية جديدة للرماية، ومسعى مختلفاً عن الشعر أو رواية السيرة الذاتية: اكتشف إمكان الرواية المائلة، وفرصة الإغارة غير الجبهية، لكن المنحرفة وغير المباشرة. ثمة نقلة بسيطة: فنِتاجه المسرحي لا يحكي مأساته الشخصية، لكنه يفتح مخرجاً من المجابهة بين الدنيا والمؤلف. ويستبدل جدران السجن، صانعاً فاصلاً مختلفاً: هو خط الإضاءة والمساحة الموجودة بين الجمهور والمنصة ـ خشبة المسرح. من الآن فصاعداً سيُهاجم نِتاجُه المسرحي الصورة التي يرسمها المجتمع لنفسه.
يعمل مسرحُ جُنيه، عبر مرآة التمثيل، على جعل وجوه «الآخر» تلوح وترتسم على تلك المرآة «من الجانب» لاحتْ بواكير هذا التحريف، أي تغيير التمثيل وإفساده بشكل ما، منذ مسرحية الخادمتين، ثم تَطرَّف وتطوَّر في مسرحيات جنيه الثلاث الكبرى، تلك التي تضعه في النسق الأول بين المؤلفين المسرحيين في القرن العشرين: الشرفة LE BALCON، والزنوج LES NEGRAES، والسواترLES PARAVENTS. لكن جنيه وهو يهاجم مبدأ التمثيل نفسه ـ كما يهاجم الصَّدَأُ المعدنَ ـ يتوصل ببطء إلى تدمير أداته نفسها وتفتيتها.
يدور كل شيء في آخر مسرحيات جُنيه، كما لو أن المؤلف يدمّر عتاده الحربي الذي يقاتل به، وينسف الرامي ومعه دريئته. كما لو أنه بلغَ حداً خفياً دون أن يدري، وبرغم الجهود التي بذلها عبثاً ليكتب مسرحية جديدة، وبرغم الفضيحة الصاخبة التي أحدثها إخراج مسرحية السواتر على مسرح أوديون – في باريس ـ توقف جُنيه عن الكتابة وانسحب من ملعب الأدب والتزم الصمت طوال خمس وعشرين سنة.
العيد الأخير أو إبداع الخيال السياسي
إنها السياسة التي زَوَّدتْه بالطلقات الأخيرة في جعبته. سيكتشف جُنيه ـ على تخوم سبعينيات القرن العشرين ـ مع الفهود السود الأميركيين، والمهاجرين من المغرب إلى أوروبا، والمقاتلين الفلسطينيين، نوعاً من الطريق الثالثة، ويعثر على طريقة أخرى لمتابعة حربه الشخصية. سيعود جُنيه وهو في الستين، من مخيمات الفلسطينيين في الأردن إلى معازل السود في أميركا، إلى ما كان عليه في مطلع حياته: متشرداً. وسيتحول ذاك الذي كان «شاعر أضيق مدى في العالم ـ الزنزانة» ـ إلى محرر يوميات الحروب الكونية. في جوار المهمشين يقوم جُنيه باكتساب عدة مهارات: يكشف المدى الجَمعي المشتَرك للثورة. كما يكتشف وجودَ عائلةٍ تضم أولئك الذين قطعوا صلاتهم بكل عائلة، ويقبل التلفظ بمفردات كانت مطرودة من لُغته مثل كلمة أخ مثلاً، التي يستعملها السود الأميركيون كثيراً. وهي كلمة سبق له أن قال عنها إنها أكثر كلمة يشمئز منها في الدنيا من ذلك أيضاً كلمة «عيد» التي دَوَّنَتْها رواية ـ سيدتنا عذراء الزهور ـ بين المفردات التي ينبغي العزوف عنها من أجل البقاء على قيد الحياة في السجن. وهو يعطي لهذه الكلمة تعريفاً قوياً: فهو لا يُعَرّفها بأنها السعادة البلهاء «بأن نكون معاً» وهو ما يَشعر بهوله ويَستَفظِعه، بل إنها السعادة «بالإفلات من الجماعة من أجل الالتحاق بمكان نَجدُ فيه متواطئين معنا ضدها [ضد الجماعة. تواطؤ مضاد للجماعة: الحرب لمّا تنته بعد… لكن كتابه الأخير المُدَوَّن في ظل المرض والموت، الذي أهداه إلى آخر ثورات القرن العشرين، كتاب أسير عاشق، فهو أكثر كتبه مَرَحاً ورشاقة وشفافية.
ربما ستكون عَظَمة جُنيه ـ لنخاطر بكتابة هذه الكلمة المضحكة: عظَمة ـ في أنه لم يُلق السلاح، ولم يصبح «ظريفاً»، كما لم يصبح عجوزاً سوقياً محترماً.
كتبَ وهو في السابعة والثلاثين من عمره في «يوميات اللص»: ـ لقد فزتُ عنوة ـ لكن هذا المنتصر لم يستسلم لمجده، ولم يلتحق بمعسكر المنتصرين، ولم يَعُد إلى حضن العائلة. لقد بقي مقيماً إلى النهاية، رغم الجميع، وضد نفسه أولاً، في هذا المكان حيث وَضَعه المجتمعُ منذ الولادة، المكان الأكثر تَوَحُّداً ووحشة، والأكثر سكاناً في هذه الدنيا: «بَرَّه»…
(كاتب سوري)
1ـ ألبير ديشي: محافظ صندوق جان جُنيه في مؤسسة «ذاكرة النشر المعاصر» الفرنسية..I.M.E.C له أكثر من كتاب عن جنيه.
السفير
في الذكرى المئوية لجان جينيه: مديح الخيانة!
محمد الفحايم
خلدت فرنسا خلال عام 2010 مئوية الكاتب جان جينيه (1910 ـ 1986)، فأقيمت منتديات وأنجزت قراءات وظهرت إصدارات تتناول منجز هذا المشاغب الأبدي الذي صدح طوال عمره بمقته للمجتمع الفرنسي، ورفع عقيرته معارضا لسياساته، متفاخرا بخيانته له، مشرعنا سرقاته وجنوحه إلى جنسانية مثلية .
كدأبها خصصت المجلة الأدبية الفرنسية Le magazine litt’raire لعدد كانون الاول ( ديسمبر) 2010 ملفا كبيرا للكاتب، فتداعى الكتاب من ذوي الاختصاص إلى تقديم قراءات تقارب وجوه الكاتب المتعددة: شعرا ومسرحا ورواية ومواقف وقناعات سياسية ووجودية تثير حفيظة المجتمع الغربي العنصري ( وليس الوجه الإنساني منه)، وتنبه الضمائر الحية فيه إلى القضايا الإنسانية العادلة ( عنيت مساندة واحتضان جان جينيه لقضية الفهود السود في أمريكا، وقضية الفدائيين الفلسطينيين في كفاحهم ضد العدو الصهيوني المحتل، التي أثمرت نصين شهيرين للكاتب: ‘ أربع ساعات في شاتيلا’ و ‘ الأسير العاشق’*، ناهيك عن مناصرته لقضايا العمال والطلاب والهجرة، وخروجه في مظاهراتهم..) .
النص التالي مدين بأفكاره للمقالة الممتازة للكاتب Patrice Bougon : ‘المبشرون الكبار بجان جينيه’، المنشورة ضمن عدد المجلة الأدبية المذكور .
النص:
غالبا ما يتم اختزال أعمال جان جينيه في ما قاله جان بول سارتر في كتابه الضخم الذي كرسه للكاتب، بعنوان ‘ القديس جينيه : ممثلا وشهيدا’ . وإذا كان هذا العمل الفريد قد جعل شهرة الشاعر تطبق الآفاق، فإنه ينبغي ألا يحجب الدور الذي قام به الشاعر جان كوكتو الذي يعد أول من قدم جينيه للجمهور..
صنيع جان كوكتو
من المعروف أن جان جينيه قد نشر نصه ‘ المحكوم بالإعدام’ على نفقته عام 1941، وكانت نصوص أخرى له تقرأ خفية وتنقل من يد إلى أخرى سرّا، لأن محتواها القائم على إيروسية مثلية يعرضها للمنع والمصادرة، بسب انتهاكها الصارخ للذائقة البورجوازية..بيد أن الشاعر جان كوكتو الذي قرأ هذه النصوص الشعرية فانبهر بها بل وقع في أسرها، هو من يرجع إليه الفضل في إخراجها من دائرة التداول السري المحدود إلى جعلها تحوز مكانة بارزة في المشهد الأدبي الفرنسي. اعتبر كوكتو في مذكراته هذا الكتاب بمثابة قنبلة، ورأى فيه حدث العصر الأكبر. هكذا سيسعى كوكتو إلى إقناع الوسط الأدبي لتلك الفترة بالقيمة الأدبية لهذا الكاتب الناشىء. أما الشاعر الكبير بول فاليري فإنه سيخيب ظن كوكتو حين حدثه عن كتاب جينيه، وطلب رأيه فيه، فما كان من فاليري إلا أن قال: ‘ أحرقوا هذا الكتاب!’. فعقب جان كوكتو على قوله: ‘ إن فاليري معتوه، أهذا هو الذكاء؟’. وأطلق الكاتب اليميني المحافظ ‘ فرانسوا مورياك’ على كتابة جان جينيه: ‘ الكتابة الغائطية’ excr’mentielle .
وفي الرابع عشر من ايلول ) سبتمبر( 1943، سيشير كوكتو إلى رد فعل كاتب مهم في شبكة دار النشر الشهيرة ‘ غاليمار’: ‘ في اللحظة التي قرأ فيها مارسيل جوهاندو الكتاب قام بمهاتفتي، لقد وجد أن الكتاب ينم على عبقرية وغنائية لم يسبق إليها أحد حتى يومنا هذا ..’ . غير أن جان جينيه، في رسالة له إلى الناشر Barbezat مؤرخة بتاريخ 8 تشرين الثاني ( نوفمبر) 1943، سينقض الصورة الافتراضية للكاتب: ‘ أريد أن ألفت انتباهكم إلى شيء واحد، فما يهمني هو الحصول على المال، إن أمر نشر كتابي بعد مئة عام لا يعنيني، لكني في حاجة إلى النقود’.
سيبدأ الاعتراف الرسمي بالكاتب مع صدور كتاب الفيلسوف جان بول سارتر عن جينيه، وهو الكتاب الذي ضمن الشهرة للكاتب الملعون، وأثار بسبب قراءته الفلسفية للكاتب وأعماله، وإسقاطاته عليه عبر تطبيقه منهج التحليل النفسي الوجودي La psychanalyse existentielle، أثار حفيظة النقاد الآخرين من خصوم سارتر، الذين لا يشاطرونه رؤيته المذهبية ولا منطلقاته الايديولوجية، فانبروا للردّ على رائد الوجودية الفرنسية بقراءات تنطلق من زوايا نظر مخالفة. وهي، على كل حال، قراءات أضفت الغنى والتعدد على نصوص جينيه، ويحسن التمثيل لهؤلاء المناوئين بالكاتب والمفكر جورج باطاي الذي خص قسما من دراسته ‘ الأدب والشر’ ( 1957 ) لجينيه، أو قراءة الشاعر ميشيل دوغي الذي ينكر القراءات السياسية لمسرح جينيه، ويتهمها بالإسراف والغلو في التركيز على بعد الإلتزام وربطه بالنص الإبداعي، ويقترح قراءة شعرية لأعماله تركز على اللغة والوجوه البلاغية واستعمالاتها .
كما اهتم الفليسوف جاك دريدا بالكاتب، ورأى أن كتاباته تتأبى على كل شبكة قراءة فلسفية أو تحليلية نفسية أو أخلاقية . مثلما ركز الناقد والروائي فيليب سولرز في مقاربته للشاعر على عزلته الجذرية وفكره القائم على الجريمة والخيانة ( خيانة فرنسا بوصفها جهاز قمع وإقصاء ما جعل الكاتب يعتبر نفسه غريبا عنها لا يتورع في إحراجها ونقدها، يرفض جان جينيه فرنسا لأنها رفضته) .
ويجمع هؤلا ء جميعا تشديدهم على الوظيفة الشعرية وعلى الاستعمالات اللغوية عند الكاتب، وتقليلهم من شأن القراءات الأيديولوجية السياسية لأعماله التي تصدر عن مفهوم الالتزام كما نظّر له سارتر وتداوله أشياعه .
إن انبهار الوسط الأدبي بأدب الكاتب أواخر الأربعينيات وخلال عقدي الخمسينيات والستينيات، يكمن في المفارقة التالية: كيف لكاتب لم يتلق تعليما منتظما جامعيا، ولم يتخرج في المدارس المعلومة أو الجامعات المشهورة، كاتب نشأ في الإصلاحيات وصرف أعواما في السجون، ليس له من الشهادات سوى شهادة الدروس الابتدائية، كاتب عصامي تربى على الروايات الشعبية الرخيصة، كيف له أن يكتب بهذه اللغة الأدبية التي بلغت مدى من الإتقان والكمال والصفاء جعلته يبذ شأو كتاب عصره اللامعين، ويجترح لنفسه مكانة سامية بينهم، يكنّ لها الفحول منهم كل الإكبار والإجلال ..
سعى جان جينيه في حوار معه إلى تنوير الحائرين الذين طرحوا هذا السؤال: يقول السائل: ‘ أبهرتم الملأ بلغتكم الكلاسية، لغة لم تقصدوا خلخلتها. في البداية، من علمكم كتابة الفرنسية بهذه الإستقامة؟’
ويجيب جان جينيه بكلام لا يخلو من مكر :
‘ النحو هو معلمي … ما كان عليّ قوله للخصم، ينبغي تبليغه له في لغته وليس بواسطة العامية التي يمكنها أن تكون لغة غريبة. لا ينبغي للسجين الذي كنته أن يكتب على طريقة سيلين ( بالعامية )، يلزم أن أخاطب الجلاد في لغته (…) لا يسعني قول أشياء استثنائية وخاصة جدا إلا في لغة تعرفها الطبقة المهيمنة، ينبغي أن يصغي إليّ أولئك الذين أنعتهم بـ ‘ سجاني’، يتوجب إذا أن ألحق الأذى بهم في لغتهم، أما إذا خاطبتهم بالعامية فلن يصغوا
إليّ .
صنع جان جينيه قدره بمفرده، وقاده هذا القدر إلى العيش على هامش مجتمع أقصاه وحشره في زنازن وحيدا غريبا إلا من تأملاته التي صاغها في صورة أشعار وروايات ومسرحيات، تصرخ عاليا في وجه هذا النفي والإبعاد، ولا تخجل من مديح الخيانة والسرقة والمثلية بوصفها أشكال احتجاج تثبت الذات وترسخ الذاكرة وتقاوم النسيان. رحل الرجل لكن أعماله ومواقفه ستظل باقية تثير الجدل ويسهر القوم جراها ويختصمون .
هامش :
‘ الأسير العاشق’ هو الكتاب الأخير لجان جينيه، صدر عام 1986 ويؤرخ لعودة الكاتب إلى الكتابة بعد انقطاع وصمت أدبي دام زهاء عشرين سنة، يقول عنه Albert Dichy وهو مختص في أعمال الكاتب، ألف كتبا، وكتب فيلمين وثائقيين عنه، هما: ‘ جان جينيه المتشرد’ و ‘ جان جينيه الكاتب’: ‘ إذا كان قد وجد عند الفدائيين، في حالة حرب، الرغبة في العيش والكتابة التي كان قد فقدها، فذلك لأنه ـ وهو المنفي بين المنفيين ـ يعثر، بلا شك، بجوارهم على وطن بالتبني، على أرض للملاذ العابر، على فضاء مفارق من الطمأنينة والسلام في أتون الحرب. في قلب الحكي يعبر، مثل طيف، وجه الأم التي لم يعرفها خلال حياته، والتي يبتكرها انطلاقا من ملامح عجوز فلسطينية’.
قصائــد لجــان جُنيــه
أتقـــدم فـــي ليـــل ســـائل
كنت نشرت منذ فترة قصيرة، (السفير الثقافي في 10 كانون الأول الحالي) جزءا من قصائد جان جينيه التي قمت بترجمتها إلى العربية، والتي ألقاها في المركز الثقافي الفرنسي في نابلس وغيرها من المدن الفلسطينية، الممثل رجب ميتروفيستا، حيث شكلت هذه القراءة سلسلة من قراءات متعددة، في أكثر من مدينة وبلد، تحية إلى الكاتب الفرنسي الراحل.
هنا جزء ثان من هذه القصائد التي عرف بها جينيه على الشكل التالي: «أهديت هذه القصيدة إلى ذكرى صديقي موريس بيلورج الذي لا يزال جسده ووجهه المشع يؤرقان ليالي الساهدة. عبر الروح، ما زلت أحيا مجددا معه الأيام الأربعين الأخيرة التي أمضاها، مكبل القدمين، والمعصمين أحيانا، في زنزانة المحكومين بالإعدام في سجن سان ـ بريو.
كانت المعلومات تنقص الصحف. لقد دبجت مقالات رعناء كي تزين موته الذي صادف مع بداية مهمة السفاح ديفورنو. وفي تعليقها على موقف موريس أمام الموت، قالت الصحيفة التحفة: «كان هذا الصبي جديرا بمصير آخر».
باختصار لقد أذلوه. بالنسبة إليّ أنا الذي عرفته وأحببته، أرغب هنا، وبأهدأ طريقة ممكنة، وبحنان، في أن أؤكد بأنه كان جديرا، من خلال بهاء روحه وجسده المزدوج والفريد، بأن يستحق موتا مماثلا. كل صباح، حين كنت أذهب ـ بفضل تواطؤ أحد الحراس الذي سُحر بجماله وشبابه ونزعه الشبيه بنزع أبولون ـ من زنزانتي إلى زنزانته كي أحمل له بعض السجائر، كان ينهض باكرا ويدندن ويحييني مبتسما: «مرحبا، يا جانو الصباح!».
تمّ اعدامه في 17 آذار (مارس) من عام 1939 في سان ـ بريو».
آه لتجتز الحائط؛ وإن توجب الأمر سِرّ على حافة
السقوف، المحيطات؛ غطِّ نفسك بالضوء،
استفد من التهديد، استفد من الصلاة،
ولكن تعال، آه يا فرقاطتي، ساعة قبل موتي.
مخبئي المعشوق في ظلّك المتحرك
اكتشفت عيني سرّا بالصُدفة
نمت غفوات يجهلها العالم
حيث ينعقد الرعب.
أروقتك المظلمة منعرجات القلب
وحشد أحلامها تنظم بصمت
آلية تملك من الزجاج
شبهه وقساوته.
ليلك يدفع عيني وصدغي إلى الجريان
موجة حبر ثقيلة جدا لدرجة أنها تُخرج منها
نجوم أزهار كتلك التي نراها دفعة واحدة
حين أبلل الريشة بها
أتقدم في ليل سائل حيث تتحدد
مؤامرات غير محددّة ببطء.
من أنادي لنجدتي؟ تتحطم جميع حركاتي
وصرخاتي تصبح رائعة.
لن تعرفوا شيئا عن ضيقي الأصمّ
سوى هذا الجمال الغريب الذي يفشيه الليل
ينهمك الداعرون الذين أسمعهم بعد دورانهم
المستمر بالهواء الطلق.
يرسلون إلى الأرض سفيرا وديعا
طفلا بدون نظرة ترسم مساره
نازعين الكثير من الجلود حتى تكتسي رسالته
الفرحة بهاءها
تشحبون من الخجل حين قراءة القصيدة
التي يخطها المراهق ذو الحركات المجرمة
لكنكم لن تعرفوا شيئا من العُقد الأصلية
الخاصة بعنفي المعتم.
لأن العطور الفائحة في ليله، قوية.
سيوقع اسم بيلورج، وسيكون تعظيمه
المقصلة الواضحة التي تنبجس منها الورود
وأثر الموت الجميل.
حركاتك التي من دانتيلا، تلفك برهافة
كتفك مسنود على نخلة تحمرّ
تدخن. ينزل الدخان في بلعومك
بينما السجناء، يرقصون بوقار،
بجسامة، بصمت، كل واحد بدوره، يا أيها الطفل
سيأخذون من على فمك قطرة معطرة
قطرة، لا اثنتين، من الدخان المدور
الذي يسيلها لسانك لهم. يا أيها الأخ المنتصر
يا ألوهة مرعبة، خفيّة وشريرة
تبقى هادئا، حادا، من معدن واضح
منتبها إلى نفسك فقط، موزعا قدريا
مرفوعا فوق خيط أرجوحتك التي تغني.
آه، أشر إليه في شيخوخته التي تشتعل
واذهب لتضنيني! لديّ وقت قليل
وإن جرؤت، تعال، اخرج من بُرَكِك
من مستنقعاتك، وحلك الذي تصنع منه فقاعات
يا أرواح الذين قتلتُهم! اقتليني! أحرقيني!
يا ميكل أنجلو السقيم، نحتّ في الحياة
لكن الجمال، يا سيدي، خدمته دائما،
بطني، ركبتاي، يداي الزهريتان من الاضطراب.
ديكة القَنّ، القُبّرة الغالية،
عُلب بائع الحليب، جرس في الهواء،
خطوة على الحصاة، بلاطي الأبيض والواضح،
هو اللامع الفرح على سجن الأردواز.
سادتي، لست خائفا! إن استدار رأسي
في صوت السلّة مع الرأس الأبيض،
بفرح أضع رأسي على وركك النحيل
أو لمزيد من الجمال، على عنقك، يا فروجي…
انتبه! يا ملكا مأساويا ذا فم موارب
أصل إلى حدائقك التي من رمال موحشة،
حيث تنتعظ، مذهولا، وحيدا، واثنتان من أصابعك في الهواء،
ورأسك مغطى بحجاب صوفي أزرق
وعبر هذيان أحمق أرى قرينك الصافي!
يا حب! يا أغنية! يا ملكتي! أهو شبح ذكري
شُوهد خلال الألعاب في حدقتك الشاحبة
من يتفحصني هكذا على جصّ الجدا؟
لا تكن قاسيا، اترك ماتين تغني
لقلبك البوهيمي، امنحني قبلة واحدة…
يا إلهي، سأنكسر بدون أن أستطيع دفعك
في حياتي ولو لمرة على قلبي أو قضيبي!
أو دون أن أشيخ، أموت، أحبك يا سجني
مني تنساب الحياة إلى الموت المجدول.
تمّ رقص الفلس البطيء والثقيل بالمقلوب
كل واحدة تردن بمنطقها الرفيع
بشكل متقابل.
لدي بعد مكانا واسعا ليس قبري
كبيرة هي زنزانتي وصافية نافذتي.
وفي الليل الجنين أنتظر أن أولد مجددا
أترك نفسي حيّا عبر شارة أعلى
من الموت
ما عدا السماء، أقفل أمام الجميع
بابي، ولا أمنح دقيقة صديقة
إلا للسارقين الشبّان الذين تنتبه لهم أذني
من أي أمل قاس يجيء النداء لنجدتي
في أغنيتهم المنتهية.
نشيدي ليس ملفقا إن ترددت أغلب الأحيان
بعيد هو ما أبحث عنه تحت أراضي العميقة
وأحمل دائما مع الآلات عينها
منتقيات كنز دُفن حيّا
منذ نشأة العالم.
إن استطعتم رؤيتي منحنيا على طاولتي
وجهي مهزوم من أدبي
لعرفتم كم تُنفرني هذه المغامرة
المرعبة في أن أجرؤ على اكتشاف الذهب المخبأ
تحت الكثير من النتانة.
سامحني يا الهي لأني أخطأت!
دموع صوتي، حرارتي، عذابي،
ألم أن أطير من بلد جميل كفرنسا،
ألا يكفي هذا، يا الهي، كي أذهب وأنام.
مترنحا من الأمل.
في ذراعيك العــطرتين، في قصـــورك الثلجية!
يا سيد الأمكنة المعتمة، ما زلت أعرف أن أصلّي
إنه أنا يا أبي، من صرخ ذات يوم:
المجد للعلى للرب الذي يحميني
يا هرمس القدم الحنونة!
أطلب من الموت السلام، النعاس الطويل،
نشيد الساروفيم، عطرها، زينتها،
ملائكة الصوف الصغيرة ذات النثار الساخن
وآمل بليالي بدون أقمار وشموس
فوق أراض ثابتة.
لن أعدم بالمقصلة هذا الصباح.
يمكن أن أنام مطمئنا. في الطابق الأعلى
حبيبي الكسول، لؤلؤتي، يسوعي
يستيقظ. سيضرب ببسطاله القاسي
جمجمتي الحليقة.
فجر فرح يتشظى في عيني
يشبه صباحــا صافــيا كســجادة على البلاط
لتخنق مشيتك عبر متاهة
الأروقة المخنوقة التي تضعها عتبتك
عند البوابات الصباحية.
ترجمة/ إسكندر حبش
السفير




