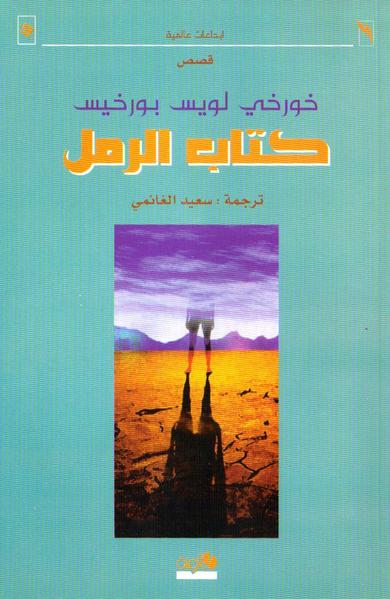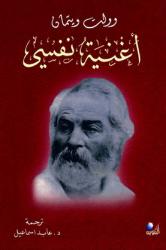كارولين فورست..العلمانية على محك الأصوليات اليهودية والمسيحية والإسلامية

كارولين فورست..العلمانية على محك الأصوليات اليهودية والمسيحية والإسلامية
http://www.4shared.com/document/czkfgoTF/_-___.html
مهما اختلفت الأصوليات التوحيدية الثلاث ومهما تنافست فيما بينها في ادعاء التمثيل الأحقّ للقانون الإلهي، فإنها لا تتوانى ثلاثتها عن تحييد خلافاتها لتتآزر وتتعاضد في مواجهة العلمانية والديمقراطية لأنهما تأخذان بالقانون البشري.
سيبين لنا هذا الكتاب، الذي يرصد الحركات الأصولية في المشرق وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ، كيف تؤدي الأصوليات الثلاث الخدمة لبعضها بعضاً سواء عن تخطيط متعمَّد أو بصورة تلقائية نتيجة لتلاقي مصالحها، وكيف تعتمد جميع الحركات الإيديولوجية واللاهوتية والسياسية التي تنتمي إليها أساليب متماثلة في العنف والأذية عندما تستشعر أي خسارة أو هزيمة مهما صغرت. والتكتيك الذي تتبعه هذه الحركات جميعاً هو السعي إلى خلق أجواء من التوتر والفوضى في كل الساحات لإثارة الخوف والرهبة في نفوس الأفراد، إدراكاً منها أن الخوف يدفع دوما بالأفراد إلى التعصب وإقصاء العقلانية، مما يتيح لقادة هذه الحركات فرض إرادتهم ووصايتهم على جماهير واسعة.
ولئن لم يعد من خيار أمام الأصوليين اليهود والمسيحيين سوى خوض معاركهم في مواجهة العلمانية من موقع دفاعي، فإن الأصولية الإسلامية، التي استفادت على مدى عقود من التمويل النفطي وتحولت إلى إيديولوجيا سائدة، تميد الآن انتصارا بعد انكسار النهضة في البلدان التي تدين بالإسلام، وخاصة العربية منها، وبعدما تمكنت من شق الصف العلماني ليتشكل فريق جديد يأخذ بالعلمانية الرخوة في محاولة لكسب رضى الإسلامويين.
وتَعتبر مؤلفتا هذا الكتاب أن الحاجة ماسة الآن إلى بناء حركة علمانية عابرة للثقافات وقادرة على تفكيك الحلف غير المقدس الذي جمع في العقود الأخيرة بين الناشطين تحت لواء المقدس في عدائهم المشترك للعلمانية والعلمانيين.
من المقدمة
قرع الحادي عشر من أيلول سبتمبر بدءَ مرحلة وعي الخطر الذي تمثله الإسلاموية. وبالمقابل فإنه لم يؤد إلى تفكير مُعَمَّق حول عودة سائر الأصوليات بقوة. مع أن هذه الصدمة الجارحة ـ التي فسَّرها بعضهم بسرور على أنها صدام حضارات ـ لا يمكن فَهمُها دون إلقاء نظرة على عودة الغزوة الدينية التي باشرها ـ في آن معا ـ الأصوليون اليهود والمسيحيون والمسلمون منذ نهاية السبعينات. إنها ثأر الله، إذا استرجعنا صيغة جيل كيبل G. Kepel.
تشير هذه الحقبة إلى منعطف ضمن نطاق عَرفتْ فيه الأديان الموحدة الثلاثة عملية تطرفٍ سياسي في تواريخ متقاربة بشكل مدهش.
ففي شهر أيار-مايو 1977، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، أحدثت الأحزاب الدينية خرقاً انتخابياً أدّى إلى منع حزب العمل من تشكيل حكومة، مما خدم مصلحة حزب ليكود. وفي السنة التالية أصبح كارول ﭭوتيلا Wojtyla، وهو كاردينال بولوني معروف بتصلبه، أصبح البابا يوحنا بولس الثاني. وبدأ معه زمن تطرف مواقف الكنيسة الكاثوليكية، التي تُعزَى بشكل خاص إلى عودة الكاثوليكيين التقليديين إلى الكنيسة بعد أن كانوا وصلوا إلى حد الانشقاق عنها تعبيراً عن الاحتجاج ضد المجمع المسكوني المعروف باسم «فاتيكان الثاني».
حمل العام 1979 خاتم حال راهنة مزدوجة: حال الإسلاموية وحال الأصولية البروتستانتية. ففي شباط-فبراير يُعلن آية الله الخميني جمهورية إيران الإسلامية، الظاهرة الأولى لغزو الإسلاميين مواقع السلطة. وسنة 1979 هي أيضاً موعد ولادة اليمين الديني الأمريكي رسمياً، بخاصة ولادة التحالفات الكبرى مثل الأكثرية الأخلاقية MORAL MAJORITY، وهذا يعني بداية استيلاء السلفيين البروتستانتيين على الحياة الداخلية وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
بعد هذا المنعطف، نُزعت السمة الإطلاقية، في أغلب الأحوال، عن التحليلات التي تنبأت بالتبعات الخطرة للصدمة المعاكسة الدينية. ومَرَّ وقت دون ظهور أية عدوى عالمية بشكل مشهود، مما أغرى بعض المحللين بالاعتقاد بشكل ما من أشكال استيعاب الأصوليين واندماجهم. وجاء الحادي عشر من أيلول سبتمبر ليُعكّر تماماً هذا التفاؤل، ولكن إدراكه تمَّ على أساس أنه عمل إرهابي ينبغي أن يجعلنا واعين الخطر الوحيد: الإسلامي.
أعطى عنف هذا الحدث المشهود أثراً تبشيرياً، حيث أصبح العمل الانتحاري (الكاميكازه) تجسيدا لهمجية يستمدها الإسلام من جوهره الذاتي، ليس هذا فحسب ولكن تجسيداً لهمجية ينبغي أن تُنسينا ما عداها كله.
انفعلنا وتأثرنا عندما وصل ﺴﻴﻠﭭيو برلوسكوني إلى ادّعاء تفوق الغرب، ولكننا انضممنا إلى صيغة «صدام الحضارات»، بل حتى إلى حرب الغرب ضد الشرق، والخير ضد الشر، والمسيحيين ضد المسلمين… على النقيض ـ من هذه الرؤية ـ تنافَسَ بعض المفكرين الأوروبيين ـ وقد أرعبهم خطر عدوى عنصرية ـ في بذل طاقاتهم لكشف ما أطلقوا عليه اسم «رهاب الإسلام»، مع احتمال أن يُضيّق موقفُهم هذا المدى الضروري للقيام بنقد علماني للإسلام.
من بين هذين الإغراءين، الشيطاني والملائكي، وُلدت الرغبة في دراسة التأثير الخاص والمتضافر لكل أصولية من الأصوليات اليهودية والمسيحية والإسلامية، الموحَّدَة بالالتزامات نفسها. ولمزيد من الدقة، فإن المقصود المقارنة بين التظاهرات السياسية الجذرية للحركات التي تتبنّى مبادئ التوحيد والمسماة أيضاً «الأديان الإبراهيمية»: اليهودية، والمسيحية (كاثوليكية وبروتستانتية) والإسلام. وقد بدت لنا هذه المقاربة العرضانية الوسيلة الوحيدة لتفادي التنديد والوصم لصالح القيام بتحليل ملموس وظرفي. هل يتقاسم الأصوليون المسيحيون واليهود والمسلمون ـ في الواقع ـ نظرة واحدةً متشابهة إلى العالم؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، هل يكون وَقْع أفكارهم على حياة الآخرين وتأثيرها متماثلين تماما؟ وإذا كان الجواب سلبا، أينبغي لنا البحث عن تفسير هذا الاختلاف في طبيعة دينهم نفسه أو في السياق الذي يتحركون فيه والخاص بكل دين، آخذين بالاعتبار وزن المقاومات والكوابح المضادة التي يواجهها كل فريق منهم؟
غير أن المسألة الحقيقية التي يطرحها هذا الكتاب تظل كما هو آت: أَيَخوضُ السلفيون حربا بعضهم ضد بعضهم الآخر، أم أنهم يعملون معاً لإتلاف الديمقراطية والعلمانية وإفسادهما، وغايتهم تحقيق هدف مُشتَرك، مع احتمال تعزيز كلٍ منهم الآخر وتقويته؟ وبصيغة أخرى، هل يمثل خطُّ الصَّدْع الحالي بينهم صدام حضارات أم على النقيض صدام أفكار بين الثيوقراطية والديمقراطية؟
من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة، فلنُفْصح عمَّا نعنيه بكلمة «أصولية». نحن ننهض بعبء موقعنا العلماني الذي يقتضيه هذا الموقف. فليس الموضوع هنا المقارنة بين أديان الكتاب بل المقارنة بين الإدّعاءات والمطالب السياسية التي تُقدَّم باسم هذه الأديان. نحن لسنا مفسرتين ولا مُؤَوِّلتين للكتب المقدسة. لكننا ـ بالمقابل ـ نعتبر من حق كل مواطن سؤال المراجع التي تُقدّمها الحركات الأصولية لكي تفرض عليه رؤية للحياة في المجتمع، وهي هنا شريعة إلهية تُعتبر متفوقة على قانون البشر. وتعني «الأصولية» في رأينا تَجَلي مشروع سياسي هادف إلى إلزام مجتمع ما، بدءا بالفرد وانتهاء بالدولة، باعتماد قيم ناتجة، لا عن توافق ديمقراطي، بل عن رؤية للدين صارمة متشددة أخلاقية. تكلم فولتير في «المعجم الفلسفي» عن «المتعصبين» بهذه العبارة: «ناس مقتنعون بأن الروح القُدس الذي يملؤهم هو فوق القوانين». هذه السمة هي بالفعل ما نبحث عن ملاحقته عند «السلفيين»، حتى لو كانت كلمة «متعصب» اتخذت بمرور الزمن رنيناً مشوشاً لا يتيح لنا اللجوء إليها باضطراد منتظم.
لم نعتمد عبارة «سلفي» أو «سلفي جديد» ـ نيوسلفي ـ المستعملة غالباً للدلالة على السلفيين البروتستانتيين أو المسلمين. تعني السلفية، في ذاتها، عودة إلى أسس الإيمان، وإلى نصوص مقدسة يراد لها أن تُقرأ بأكثر الأساليب حرفية ورجوعاً إلى الأصل. ولئن كان هذا المشروع يؤدي غالباً إلى رؤية متصلبة وعتيقة للعالم ـ بمعنى العودة إلى الرسالة الأصلية ـ إلا أنه لا يعني، بالمقابل، وجود رغبة لدى القائمين به لفرض رؤيتهم باطراد على الآخرين. فعلاوة على أن السلفية ليست خط حدود يفصل ويميِّز سائر المتطرفين دينياً، فإنه لا يسع أية تسمية لاهوتية أن تُرضي الراغب في دراسة الإغراء السلطوي الذي تحتويه الأصولية. صحيح أن الأصوليون يتذرعون، في المقام الأول دائماً، بخصوصية دينية قد تتخذ شكل التقوى أو السلفية أو التزمت العقائدي، إلا أن هذا التحديد ليس إلا حجة وذريعة لتطرف سياسي أكثر. ونحن لن نحتفظ بهذه الصيغ إلا من أجل عرض وتحليل الخصوصيات اللاهوتية، الخاصة بكل حركة، ولكن مقصودنا الأول هو دراسة التأثير السياسي للأصوليين. وبكلمة أخرى، ليس قصدنا تحليل فحوى «السلفية الإسلامية» بدقة بل «النزعة الإسلاموية». تدل الإسلاموية على «الاستخدامات السياسية للإسلام»، تِبعاً لتعريف جاء في كتاب وضعه كل من برنار بواﺘﻴﭭو Boitiveau وجوسلين سيزاري Cesari. ولئن احتفظنا بهذا التعريف للإسلاموية، إلا أننا نُفضل عليه غالباً تعبير «أصولية إسلامية».
كما ينوّه ماكسيم رودنسون، فإن لفظة «ISLAMISTE» تحتمل مجازفة التباس معناها بكلمة ISLAMIQUE، في حين أن كلمة «أصولي INTEGRISTE» تنطوي على مزية، وهي قابلية تصريفها إلى أصوليات يهودية، أو مسيحية، أو إسلامية، مما يجعل مشروعنا للمقارنة بينها أكثر يُسرا. وأخيرا تجعل التفكير ينصرف فورا إلى النفوذ التسلطي، السياسي بالضرورة، الذي تمارسه بعض الجماعات على حياة المجتمع باسم الدين. وهذا ما يميز هذه الجماعات، بل هذا ما يجعلها مناهضة للمتدينين المتسامحين والعلمانيين.
من أجل دراسة سائر أوجه الأصوليات والمقارنة بين مظاهرها، انتقينا خمسة موضوعات، كلها سياسية، حتى ولو أمكن تصورها منتقلة من الأكثر «خصوصية» إلى الأكثر «عمومية»: فموضوع حقوق النساء، موضوع حقوق التناسل والمسألة الجنسية، موضوع التسامح الثقافي، موضوع النفوذ السياسي الضاغط على الدولة (بمعنى Lobbying)، وأخيرا موضوع النشاط العنيف والإرهابي.
اعتاد جيل كيبل على التمييز بين «الفتح من الأعلى»، عندما يحاول المتطرفون الدينيون الاستيلاء على مواقع سلطة في قمة التراتبية السياسية، وبين «الفتح من الأسفل» عندما يُرَكزون جهودهم على التبشير ميدانيا. نحن نتقاسم مع كيبل هذا التمييز، وسنعتمده في تحليلنا، ولكن مع محاولتنا عدم الوقوع في حبال الإغراء القائل بأن أحدهما أكثر أهمية من الآخر. وبالفعل، يميل كثيرون من المراقبين إلى ألا يعيروا انتباها لظاهرات تدخّل الحركات المتطرفة إلا إذا عَبَّرت عن نفسها في المجال السياسي المُصنَّف كذلك رسميا ـ كالمساهمة في الانتخابات أو القيام بنشاط إرهابي ـ في حين أننا، نحن، لا نُقلل أبداً من أهمية تأثير هذا التدخل نفسه على الحريات الفردية، كحقوق النساء أو حقوق الأقليات.
لمّا كان هذا العمل ضخماً، فإن دراستنا ستنصرف بالضرورة إلى التركيز على بعض الأمثلة: على الكاثوليكيين التقليديين في فرنسا، وعلى اليمين الديني الأمريكي، وعلى غلاة المتزمتين اليهود الذين يعيشون في إسرائيل، وعلى بعض الحركات الإسلاموية السنية. ولم يمنعنا هذا الانتقاء من توسيع طيف دراستنا ـ كلما فرض علينا التحليل ذلك ـ ومَدّه إلى بلاد أخرى وحركات أخرى، مثل النظام الشيعي في إيران أو غلاة المتزمتين اليهود الأمريكيين. وقد يفاجأ القارئ عندما ندرج أيضاً اﻠﭭﺎتيكان أو الحركات الكاثوليكية غير التابعة للمطران لوﻔﻴﭭر Lefebvre. فرؤية الكاثوليكية هذه، رغم أنها أصبحت مؤسساتية، لا تخلو من تأثيرات أصولية ثانوية في ما يتعلق بالحق بالإجهاض، وبالوقاية من وباء نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو بحقوق المثليين الجنسيين، الذين يشن عليهم اﻠﭭﺎتيكان حرباً «صليبية» نشطة بصفته دولة وجماعة ضاغطة، وبخاصة في الهيئات الدولية. ونحن لا نهتم في هذه الحال بالأصوليين كجماعة محددة، بقدر اهتمامنا بتظاهرات هذه الأصولية. والأمر نفسه بالنسبة لليهود المتزمتين، المشمولين بهذا التعبير جميعاً، رغم وجود مستويات من التعصب مختلفة جداً لدى هؤلاء. وسنحتفظ بهذه التسمية ولكن مع حصر اهتمامنا باليهود المتزمتين الذين لخطابهم وقعا اعتبرناه أصولياً.
قد يقول معترض علينا إن الأصوليات المتنوعة ليس لها كلها لا التأثير نفسه، ولا الاعتراف العام بها، ولا الحظ الواحد بالنجاح. يبقى أنه في اليوم العاشر من أيلول سبتمبر، لم يكن هناك من يحمل على محمل الجد مقدرة بن لادن على الأذى. فلا تحتاج بعض الأقليات الفاعلة، وبعض الشبكات، إلى أن تمثل حركة شعبية كي تكون في طليعة مسار يمكنه تغيير مجرى التاريخ. فما كان بن لادن سوى «محسن» في خلية مبهمة الهوية ومبهمة الحدود معا. ولكن هذه الشبكة تدعى القاعدة وأصبحت فجأة نموذجا لا يمكن تجاهله.
منذ سنوات ونحن نعمل على دراسة حركات لا يُنظر إليها في الغالب بنفس الجد الذي يُنظر به إلى حزبٍ كحزب الجبهة الوطنية: مثل الجماعات المناهضة للإجهاض، والمسيحيين التقليديين، والقوميين المتطرفين. إذ ليس لهذه الجماعات في الواقع التموضع نفسه، ولا بالتالي التأثير نفسه. مع ذلك، يشكل الكاثوليكيون التقليديون والمناهضون للإجهاض واحدةً من القوى الإيديولوجية الناشطة في «الجبهة الوطنية»، ودراستهم لا غنى عنها لاستباق تطور هذا الحزب. أما في ما يخص القوميين المتطرفين، فقد كان الجميع يتساءلون عن الفائدة التي نعلقها على هؤلاء المتوهمين من أصحاب الرؤى، ولكن هذا كان قبل الرابع عشر من تموز-يوليو 2002، يوم محاولة اغتيال جاك شيراك… والحق أنه لا ينبغي أبداً التقليل من أهمية الدور الذي تلعبه الجماعات التي تبدو هامشية، كما يجب على الأخص ألا يغيب عن النظر كون هذه الشبكات قادرة على تغذية حركة يمكن أن تستفيد منها تنظيمات أخرى أعمق تأصلاً في أرض الواقع.
بهذه الروح رحنا نحاول أن نفهم كيف تتمكن من أن تترابط جماعات أصولية مختلفة جدا في الظاهر، بل متعارضة، سواء أكانت هامشية أم معترفاً بسلطة نفوذها. أملاً بأن يتيح لنا هذا المنهج لا تأكيد الخطوط المحددة لهوية الأصولية وتظاهراتها الأكثر وضوحاً فحسب، بل كذلك كشف المعالم التي لا يستطيع أحد رؤيتها، أو لا يريد ذلك.
http://www.4shared.com/document/czkfgoTF/_-___.html
صفحات سورية ليست مسؤولة عن هذا الملف، وليست الجهة التي قامت برفعه، اننا فقط نوفر معلومات لمتصفحي موقعنا حول أفضل الكتب الموجودة على الأنترنت…..
لقراءة الملف تحتاج الى برنامج:
Acrobatt reader
يمكن تنزيب نسخة مجانية منه من الرابط التالي
http://get.adobe.com/reader