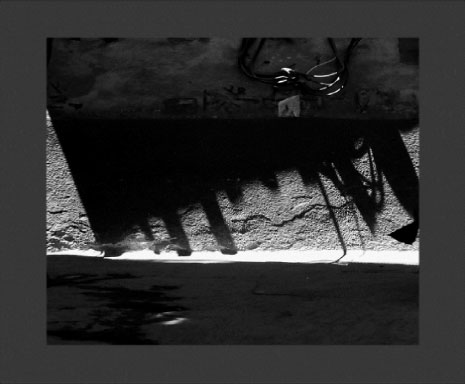ألف قصيدة وقصيدة من الشعر الأميركي المعاصر

ألف قصيدة من الشعر الاميركي المعاصر صدرت أخيرا بالاشتراك بين مشروع كلمة – أبو ظبي ودار الجمل – بيروت، اختارها وترجمها الشاعر والكاتب سامر أبو هواش، صدرت أخيرا في 15 مجلدا
آيه آر آمونز
أغنية المشي
شتوة صغيرة
ومن بعدها
الشمس،
لمعانٌ
خفيّ
يعمي العيون:
الأعلى، إذ
يرتدّ عميقاً
يترافق
مع الأخفض
والأخفض
يغزلُ عالياً
إلى مرتفعات
ليست في احتمالك.
عاطفة
كلّ ما يحيا يموت
وحتى الأنهار تجفّ أو تتدَحرج
خارج الضفاف واليابسة الناشئة
تمحو البحار أحياناً ،
وتلك الذرى المكسوة بالثلج طوال العام يبليها الزمن:
وهذا الكوكب نفسه قد تكوّن يوماً
ومع الوقت سيذوي:
لكن فكّر في صدمة التفاصيل الصغيرة
كمصادفة صديق
أو التأخّر على مباراة كرة قدم
يشارك فيها ابنك،
أو شجرة مائلة في الباحة
أفسح لها في المجال منزلٌ قديم.
عتقٌ محليّة
الغديرُ
الأقدم من المخطوطات،
يذيع الخبر:
التلالُ العارية تحت المطر،
أقدم من الهياكل:
حين يحوّل الرسّام نظره
عن لوحة “المطلق”
تبدأ اللوحة بالتصدّع:
الأعشاب الضارية
والآجام
حيث ترتفع المدن
ترخي حطام الأرض:
نفصلُ أشياءنا عن الأشياء،
لكنها تتحوّل فحسب مع التحولات
التي تبقى فوق الأشياء وفوقنا
ساخرة من
التحولات نفسها.
نهاية الدرب
وإذ بلغت جداراً صخريّاً
نظرتُ إلى الوراء
إلى الوادي اللولبيّ
وحدّثت نفسي:
أهذا أقصى ما يمكنك بلوغَه
والعقيق حطام مهترئ من بقايا كلام
نثرته الرياح،
قال الواصلون إلى هنا يرجعون:
جلستُ إذاً، عازماً
على حلّ المعضلة
وكلّ وريقة سَقَطَتْ
من أدغال عظامي
والرملُ عصفَ في العقيق
اللولبيّ ودوّم
ثاقباً
الجدار الأخير:
جلستُ في ظلّ عظامي الهشّ
وأعملتُ مفاصلَ عقلي
حتى انفلقت الأرضُ
لكي ترتّقَ الخطأ:
نهضتُ وسرتُ عبرَها.
الأعلى
الحبّةُ التي
على الذروة
تزنُ أقربَ
إلى لا شيء
يسندها جبل
بلا أحمال،
لكنها تقريباً
جاهزة للطوفان،
مكشوفة،
أمام رياح الأعالي
تتحمّلُ
قسوة أن لا
أشكالَ أُخرى لتكملها
ولا سماءَ
فارغةً
لتقودَ حلمها.
إبصار
كان مايو
قبل أن أرى الربيع
وكلمتي التي قلتُها
لمنحدرات الجنوب
قد أضعتُها،
جاءت ورحلت في غيابي:
لا تخف، قال لي الجبل،
جرّب منحدرات الشمال التالية
أو إذا استطعت التسلّق،
فاصعد إلى الربيع: لكنْ –
قال الجبل-
لا تَحدثُ الأمور هكذا
حيالَ جميع الأشياء،
فبعض ما يمضي يمضي حقّاً.
تصميم
كاملة تنزّ قطرة الماء
من عشبة الصخرة
أو من الطّحلب
وتسقط ثم تسيل
وتجري وتطرطش
ثم تتمدّد في الأعماق الدفينة،
وتندفع في المياه الضّحلة،
ورفيعةً تتناثر على المرتفعات،
بعدئذ تمضي شيئاً فشيئاً
لتدور بجانب لا شيء
سوى دوران العدم
في حركة أهرقت.
بيلي كولينز
مقدّمة للشعر
أطلب منهم أن يحملوا قصيدة
ويرفعوها عالياً في الضوء
كأنها شريحة تصويرية ملونة
أو أن يضعوا آذانهم على قفيرها.
أقول لهم أن يرموا فأراً في قصيدة
ويراقبونه وهو يبحث عن طريق للخروج منها،
أو أن يدخلوا إلى غرفة القصيدة
ويتحسّسوا جدرانها بحثاً عن زر الإضاءة.
أريدهم أن يتزلجوا
على سطح القصيدة
ملوّحين لاسم المؤلف على الشاطئ.
لكن كل ما يريدونه
ربط القصيدة إلى كرسيّ
وتعذيبها حتى تعترف.
يجلدونها بخرطوم
لكي يعرفوا ما الذي تعنيه حقاً.
بلاغة شتوية
تبدأ العبارة كمسافر وحيد
يشقّ طريقه في عاصفة ثلجية،
يتمايلُ في الريح، مغطياً وجهه بذراعه،
بينما يرفرف وراءه ذيل معطفه الهزيل.
ثمة طرق أسهل لاكتساب المعنى،
بلاغة الإيماءة على سبيل المثال.
أن تحتضن بيديك وجه فتاة مثلما تحمل إناء زهور.
أن تخرج مسدساً من حجيرة القفازات
وترميه من نافذة السيارة إلى رمال الصحراء الملتهبة.
لحظات رائعة كهذه يتوهّج فيها الصمت.
كذلك القمر المكتمل يشكّل معنى.
حين تعبره غيمة
يستعير بلاغة دراجة مستندة إلى جدار متجر
أو كلب ينام طوال بعد الظهر
على طرف الكنبة.
الأغصان العارية في الشتاء
ليست إلا شكلاً من الكتابة.
الجسد العاري سيرة ذاتية.
كلّ بحيرة لفظة، وكل جزيرة اسم.
لكنّ المسافر يصرّ على بؤسه،
يكابد طوال الليل في الثلج العميق،
مخلّفاً وراءه، على الهضاب والوديان البيضاء،
أبجدية باهتة من آثار الأقدام،
رسالة لفئران الحقول والغربان العابرة.
عند الفجر سيلمحُ الدخان عريشة
ترتفع من مدفئتك، وحين يقف مرتجفاً أمامك،
وقد كساه الجليد،
سترتسم ابتسامة على لحيته الثلجية،
وسيعبّر عندئذ عن فكرة كاملة.
أرق
بعد أن أنتهي من كلّ خراف العالم
أبدأ بتعداد الوحوش الضارية، والبزّاق،
الجمال، والقبّرات…إلخ.
ثم أتنقّل من بلد إلى بلد
ولا أوفّر حديقة حيوان
أو مربى مائي.
أغفو عند مطلع الفجر
في كابوس عن الغرق في الفيضان العظيم،
وأجدني أنادي من قلب المياه الصاعدة،
على نوح المشغول بشؤونه
بينما يمرّ بي فلكه العجيب ويبتعد في الأفق.
الآن يتحوّل المركب الأخير على الكوكب
مجردَ ظلّ صغير
ثمّ يبدأ بالاختفاء.
بينما تتقاذفني الأمواج،
أركّز على زوجين من الزراف
تبرز رقبتاهما من سطح المركب،
لكي لا أرى حياتي تومض أمام عينيّ.
بعد أن تختفي جميع الحيوانات
أطفو على ظهري مغمض العينين.
متخيلاً جميع أسماك العالم
تقفز تباعاً فوق سياج مائي
في سلسلة متتالية من الألوان.
عنواني
أيكون الموت الآن على بعد أميال من بيتي هذا؟
أتراه يزور أرملاً ما في “سنسيناتي”
أو يتنفّس على رقبة مسافر تائه
في كولومبيا البريطانية؟
أتراه منغمساً بترتيباته الخاصة،
يعبث بمكابح السيارات،
أو ينثر الخلايا السرطانية كالبذور،
أو يحلّ العوارض الخشبية في قطارات الملاهي،
بحيث لن يكترث بأمر كوخي البعيد،
الذي غالباً ما يجد الزوار صعوبة بالغة في الوصول إليه؟
أم أنه الآن يترجّل من سيارته السوداء
التي ركنها في نهاية الطريق،
ينفض عباءته المألوفة
التي يعلوها القناع كرأس غراب،
ويأتي بالمنجل من صندوق السيارة؟
هل واجهت أية مشكلة في العثور على العنوان؟
أقول له،
محاولاً بالكلام
الخروج من هذه الورطة.
نقطة التلاشي
“بتفاحة أريد أن أذهل باريس”
بول سيزان
كنت أحسبها مجرّد نقطة يخطّها بقلم الرصاص
تلاميذ الرسم في وسط اللوحة
قبل شروعهم في رسم الحظيرة والأبقار وأكوام القشّ،
أو مجرد نقطة تقاطع السكك الحديدية،
ذلك الموضع الذي يحدّق فيه المهندسون الميكانيكيون
من القاطرات
بينما يمضون هادرين في القفار الحارّة
خارجين من الأبعاد.
لكن ها أنا ذا عند نقطة التلاشي،
أنظر ورائي فأرى كل ما مضى يدنو مني:
الحظائر والأبقار، السكك الحديدية وأكوام القش،
المزارعون والأشغال…
أراها تتقلص ثم تتلاشى إلى نقطة
كأنما بفعل جاذبية أرضية أفقية.
إنني لاقط كرات يقف خلف مركز العالم ،
أو عالمٌ يراقب رشحاً بسيطاً في بنية الواقع.
أرى تاريخ العمارة يتقلّص إلى لا شيء
وجميع الخطوط المستقيمة تفترق عن نفسها
كرجال عالقين في النار.
كلّ النصب التذكارية منذ “فيدياس”
تلتقي عند هذه النقطة.
تخيل نقطة يمكنها أن تبتلع
موسوعة كاملة.
لقد بلغتُ سماء الهندسة
حيث كل خطّ في كل نظرية رياضية يتوق إلى الرحيل.
لكنّ نقاط التلاشي في الرسم تتلاشى هنا.
وإذا لم تصدقني
فانظر إلى اتجاه ظلال الزوايا المستقيمة
في مرأب بيتك.
أسمعتَ عن التفاحة التي أذهلت باريس؟
إنها أنف النملة التي استنشقت العالم.
عبور الأطلسي سيراً على الأقدام
أنتظر خلوّ الشاطئ من حشد عطلة نهاية الأسبوع
لكي أمضي إلى الموجة الأولى.
سرعان ما سأجدني عابراً الأطلسي
مفكّراً في إسبانيا،
متفقداً الحيتان والتيارات المائية.
أشعر المياه تحمل وزني المتنقّل.
والليلة أنام على سطحها الهزّاز.
أما الآن فأحاول أن أتخيل
كيف سترى الأسماك المشهد:
أخمص قدمّي
وهما
يبرزان ويختفيان ويبرزان…
عناق
تعرف حيلة الردهة:
لفّ ذراعيك حول جسدك
وسيبدو من الخلف
أن إحداهن تعانقك
يداها تشدان قميصك
وأناملها تداعب عنقك،
أما من الأمام فمسألة أخرى
بحياتك كلها لم تشعر بمثل هذه الوحدة
بمرفقيك المتصلبين ووجهك المذهول
تبدو منتظراً أن يأتي خياط ما
لكي يخيط على مقاسك سترة مجانين
يمكن أن تحتويك بشدّة.
تشارلز سيميك
إرث
هذه بطّانية أبي الرمادية.
كان يضطجع مجهولاً تحتها
مدارياً رأسه ووجهه، مبرزاً
قدمه العارية وأصابعها المنكمشة.
بعد ظهر نوفمبر عاصف،
البيت بارد، وحتى
شعاع الشمس الساطع مصقع
كما هو الآن…
مثل شريط قياس معدني
يقدّر جسد النائم،
موضع قلبه
تحت البطانية المخصصة لسرير أصغر…
أتراه كان سرير معسكرات؟ أيها المجنّدون،
أيها الأسرى! أحسب أن المرء يغطي رأسه
لأنهم يتركون ضوء الزنزانة
مضاء طوال الليل.
ملخّص فظّ
المعذّبُ الشهير يخرج في نزهة
ومن يرى هناك في الثلج؟
فتاة جميلة في ثوب عرس.
ماذا تفعلين وحدك في هذا البرد؟
أنت المعذّب الشهير الذي يخشاه الجميع
أرجوك الصفح عن حبيبي
المسجون في أعتم زنزاناتك
والذي أتمنى الزواج به…إلخ
لن أعيد لك عريسك
ينبغي تعذيبه الليلة
لم لا تحلّي محلّي
وتساعدينه على التفجّع على مصيره.
ظلت واقفة في مكانها
كانت الليل بارداً وطويلاً
بجوار المسلخ عوى كائن يشبه الكلب
ثم بدأ الثلج يهطل ثانية.
بعد فوات الأوان
لا أحد يغسل الثياب المخضّبة بالدماء.
تبقى معلقة على الحبل
بثقوب الرصاص الزرقاء
التي لم تمسّ.
في الغسق المحتشد
صوت أم
يدعو أطفالها للعشاء
فوق سطوح العالم.
أحسب أن أحد الغربان
سيذهب عوضاً عنهم.
أحسب أن الغراب الأكثر سواداً على السياج
سيضطر إلى انتعال الحذاء
ويرتقي السلالم الخلفية.
هواء الخريف
أخبرني أحدهم أنه في الصين القديمة
أجروا دراسات حول جدوى
تبديد الجوع
بالتهام الهواء.
في أحد الأقاليم النائية
كان يعيش رجل فقير
ظلّ يحاول لسنوات
تعلّم هذا الفنّ الصعب.
أخيراً، ذات يوم مجدب،
استدعى عائلته الحزينة.
خطواته الأولى
مثلما هو معروف
لم ترتفع عن الأ{ض إلا قليلاً
لكنه بعدئذ تمكن من الارتفاع
فوق الأكواخ والمباني.
هناك في الأعلى
وقف متشبّثاً بقبعته
بين الطائرات الورقية
لنقل
في يوم صاف
كهذا اليوم.
سئمت الملاحم
أحب اللحظة
التي يُقتل فيها أخيل
وحتى صديقه باتروكلوس
وذلك المتهور هكتور…
وكل أثرياء الإغريق وطروادة
الذين إلى هذا الحدّ أو ذاك
يذبحون بقدر من الاحتراف
بحيث أخيراً يعمّ الهدوء والسلام
(وتصمت الآلهة مؤقتاً)
عندئذ نستطيع سماع طير يغني
وطفلة تسأل أمها
إذا كان يمكنها الذهاب إلى البئر،
وبالطبع يمكنها ذلك
عبر الدرب الصغير الرائع
الممتدّ بين أشجار الزيتون.
الملاك الحارس
كانت جدتي تتكلم عنه كثيراً
وعن اعتنائه الدائم بنا
في تلك الأيام الجهنمية السوداء.
كانت واثقة من أنه
سيحفظني من كلّ شر.
كما أسرّت لي
أنني قد أراه يوماً ما.
نسيت أن أسألها
ما إذا كنت سأعرفه فوراً،
أم أنه سيكشف عن نفسه
في الوقت المناسب.
حتى هذا اليوم
أحدّق في وجوه جيراني.
وحتى أنني أحملق عن كثب
في مرآة الحلاقة.
منظور
في شارع طويل
حيث يمتدّ جدار الإصلاحية
وقف أحدهم لينادي
اسم ابن أو ابنة.
العالم برمته تعطّل في تلك اللحظة:
المساء الصيفي الدافئ،
الفتى على المزلجة؛
الحبيبان الموشكان على العناق
بعيداً عن الأنظار.
دوريان لوكس
حياةُ الأشجار
أشجارُ الصنوبر تهدرُ
في الظلمة المرصّعة بالنجوم،
يتحوّل احتكاك غصونها بالبيت،
عويلاً يعلن التملّك
آن أوان أن أخرج السلّم من السقيفة،
وأصعد إلى سطح البيت،
حاملة منشاراً بين أسناني،
وأقصّ تلك الفروع.
إذ ما هو الواقع
ما لم يكن تلك المقاومة الطويلة المضنية
للنصل والأنياب؟
أريد أن أنام وأحلم بحياة الأشجار،
تلك الكائنات التي تنتمي إلى عالم الصمت،
التي لا تبالي البتة بشأن المال أو السياسة،
السلطة أو الإرادة، الخطأ أو الصواب،
التي لا تريد من الليل إلا القليل،
بضع نجمات ماتت وخبا ضوؤها،
وبومة بيضاء تتنقّل بين أطرافها،
لا تريد سوى أن تغرز جذورها في الأرض الرطبة
محدثة الرعب في مملكة الديدان،
أو أن تهزّ رؤوسها الناعسة
مثل عارضات الأزياء أو قدامى الهيبيين.
لو كان في وسع الأشجار التكلم لما فعلت،
كانت دندنت همساً نغمة خضراء فحسب،
كانت رمت أكواز الصنوبر على الشوارع الفارغة
وحمّلت المسؤولية، بهزة كتف لا مبالية، للرياح الباردة.
خلال النهار تنام داخل جلدها.
بينما فوقها تتمزّق الغيوم كأقمشة بالية.
لا تخشى شمساً أو مطراً، ثلجاً أو ريحاً.
لا تخشى سوى الأعاصير والنيران.
في العواصف تنحني الصغيرة منها،
وتعرّف المسنّة أنها قد لا تنجو،
فتنحدر بينما خطوط الحياة فيها
ترتعش مكسورة عند الجذع،
وتطرح فروعها أضحية للأرض المسحوقة.
لا تصلي.
وإذا ما أصدرت صوتاً تبتلعه الريح.
ولا تبدي امتنانها للنجوم العائدة،
فقط ترشح، من مركز جراحها، نسغاً أعمق.
تلامسُ المياه بإبر وريقاتها،
ثم تنتصب واقفة وتتنفّس
وتتنفّس ثانية.
اجتيازُ الطريق
أيائل أوريك تنتظر بصبر اجتياز الطريق
والرجل الذي صار زوجي منذ ستة أشهر
والذي يحسب نفسه القديس فرانسيس
يخرج من السيارة للمساعدة،
الهواء يطيّر قميصه
وهو يتجه نحو الأيائل الواقفة في صف واحد
مثل متسابقي دراجات هوائية يفحصون مكابحهم،
ثم تنطلق معاً شامخة الرؤوس، متسعة الأنوف،
كل خطوة من خطواتها
شهادة على البطء والزخم في آن.
تعبر حارات الأوتوستراد الأربع، بطيئة كتماثيل إغريقية،
كأنها في مراسم تتويج ملكيّة،
بينما الريح الآتية من النهر
تبعثر الفراء الأبيض على ظهورها،
لكنّ زوجي يمضي قدماً
نحو الظبية التي ظلّت واقفة في مكانها تمضغ جذعاً،
ساهية عن شقيقاتها الذاهبات.
هيا امشي، يحثّها، تقدمي، يتضرّع إليها،
لكنّ الظبية المستوحدة لا تتزحزح قيد أنملة.
أخيراً يقفان وجهاً لوجه:
كائن عنيد يحدق بكائن عنيد آخر.
هكذا عرفت أن الزواج سيستمرّ.
سيمفونية الوداع
أحدهم أحبّه يحتضر،
لذا حين أشغلّ السيارة
وأشرع بإخراجها من المرآب تحت الأرض،
وينطلق الراديو صاخباً فجأة
بسيفونية “هايدن”
التي تتكرّر لازمتها ويتلاشى صوتها
بينما أناور السيارة عبر الأنفاق المعتمة
خفيضة السقوف، تابعة السهام الصفراء
على الجدران الإسمنتية الرمادية،
أفكّر فيه وهو يمضي ببطء
في أيام حياته الأخيرة الكالحة
ولا يسعني التوقف عن البكاء.
حين أصل إلى كشك دفع الرسوم أجدني مضطرة
إلى التوقف عن التفكير فيما أبحث في جيوبي
عن آخر القطع المعدنية،
ناظرة إلى الموظّف غير المبالي في بزته الزرقاء،
الذي يلتفّ شعره الأبيض
كالدخان حول عنقه السمراء،
أشكره كالبلهاء
وأقود سيارتي إلى ضوء الظهيرة الساطع.
كلّ شيء رمزي بشكل شنيع
وكلّ شيء يذكّرني بالسرطان:
شاحنة “الشفرون” وهيكلها الدائري
الملطخ برمل الطريق ورشح مطر الليلة الفائتة،
مستوعب القمامة أمام محل الزهور،
غطاؤه الذي تبرز منه باقات أعراس ميتة..
حتى رائحة شيء بسيط كقهوة
تنبعث من باب مقهى مفتوح
وعيناي تترقرقان، تتألمان في محجريهما.
ومنذ أشهر
لم أطلب شيئاً سوى نعمة الغفلة،
أن أتنقّل ببطء بين غرف منزلي الصغير
مغمورة كلياً بالنسيان.
أن أتناول الفشار ولا أتذكّر صديقي،
وقد بات هزيلاً وشاحباً، وغير قادر على الهضم.
ألا أتخيّل الأورام
تنضج تحت جلده،
ذلك الجلد الذي قبّلته، ومسّدته بأناملي،
وضغطت عليه ببطني ونهديّ، وفي بعض الليالي
حسبت بقوة أنه يمكنني دخوله،
أن أفتح ظهره كباب أو ستارة
وأن أنسلّ كسمكة صغيرة بين أضلاعه،
أن أمسّ دماغه بشفتيّ،
وبحرير ذيلي المحزّز
ألامس أحشاءه الزرقاء.
الموت ليس رومانسياً.
إنه يحتضر،
وليس مهماً شعوري تجاه ذلك
ولا رأيي به، هذه هي الحقيقة مطلقة،
أحادية البعد، الحقيقة التي لا تقاس،
نوتة سوداء على مدوّنة فارغة.
قدماي باردتان، لكن ليس بقدر قدميه،
وأمقت هذه الموسيقى
التي تغمر الزوايا الضيقة داخل سيارتي ورأسي،
التي تبطئ سير العالم بعظمتها المتوهّجة،
وتحوّل كل ما أراه أمامي
نصباً تذكارياً للحياة،
مهما يكن هذا النصب قبيحاً أو بليداً..
حتى سيارة “الفورد” القديمة قبالتي،
ذات المؤخرة المنحدرة الصدئة،
التي تضخ غيوماً كلاسيكية من الدخان الأسود
إلى الهواء الساطع،
حتى نباتات “أبو خنجر”
التي تتسلق السياج،
تزهر وتعترش بالتفاهة
وتتدفّق الموسيقى صعوداً من براعمها المفتوحة،
عابرة آخر حواف الزرقة إلى البحيرة الساكنة
لمجرّة أخرى،
كأن كل هذا الفراغ
ليس إلا فضاء من الوفرة،
وجهة ما،
أو طمأنينة
يمكننا الصعود إليها.
راي في الرابعة عشرة
بورك هذا الفتى الذي ولد بوجه قوي
يشبه وجه أخي الأكبر، الأعزّ على قلبي،
الذي كنت أمسك يده
ونقفز معاً من سقف الملعب.
وفي أماسي الجمعة كنا نشاهد معاً “توايلايت زون”
ويسمح لي بأن أحمل وعاء الفشار،
بينما نشاهد المسلسل المخيف
تحت ملاءة تصل إلى أكتافنا،
ويقول لي: “لا تخافي”.
ولم أشعر قط بالخوف برفقة أخي الأكبر
الذي كان يسمح لي بتحسّس عضلاته
التي بحجم كرة بايسبول،
الذي كان يحملني على ظهره
ويركض بي في الحيّ الموحش،
الذي ظلّ يمسك لي دراجتي الهوائية
حتى قلت له إنني أستطيع القيادة وحدي.
حين كان في الرابعة عشرة
كان شديد الشبه براي،
وحين مات في الثانية والعشرين
على جانب طريق في ألمانيا
حسبته رحل إلى الأبد.
لكنّ راي يركض في المطبخ، بقميصه المتسخ،
وجينزه الممزق،
يرفع كميه، ويقول لي:
“تحسّسي عضلاتي”.
وأفعل.
هزّات جماع الكائنات الحيّة
على المرجة لا تكف الخنافس البرية عن التزاوج.
كل زوجين يفردان أجنحتهما الصلبة
وينضمان إلى بعضيهما.
يضيئان في شعورنا، وعلى أذرعنا،
ثم يسقطان متلاصقين في حجورنا.
وتحتنا، في العشب، يبحث البق عن بعضه،
قرون استشعاره المنتصبة ترتعش،
أقدامه الدقيقة تعدو،
ثم الآهات متناهية الصغر للقاء كل زوجين،
الفرح الغريب لطيرانهما.
على امتداد العشب يلتقيان ثانية،
وينتشيان مثلما يمكن البق وحده أن يفعل.
لهذا السبب، أحياناً،
نحسّ بذبذبة العشب تحت أقدامنا،
كل عشبة ترتجف، والهواء ينحلّ فوق رؤوسنا
ويصطخب حول أذاننا كالمطر.
لكن ينبغي أن يكون فصل الربيع،
وأن تكون مغرماً،
بل مغرماً إلى حدّ الوجع،
إلى حد الألم،
لتسمع كورس تنهداتها المجلّلة بالسواد.
كيم أدونيزيو
معرفة
رغم معرفتك بمقدرة البشر على الشرّ،
رغم اعتزازك بمعرفتك هذه، بعدم تجنّبك التاريخ،
ولا نشرات الأخبار، ولا كل التعبيرات اليومية الصغيرة
عن قسوة البشر…
رغم هذا كله
كلما حدث شيء ما من هذا القبيل،
تشعرين حياله بالصدمة وكأنه أمر جديد، \كأنك أمضيت حياتك كلها معتقدة بأن الإنسانية في جوهرها طيبة،
وكأنك لم تفكّري على غرار شوبنهاور،
أنها مجرد إرادة عمياء،
وكأنك لم تنشدي بانحراف وبنوع من الفرح
جميع النعوت التي أطلقها “هوبس” على الحياة؛
بأنها مجرد عزلة، وفقر، وشر، ووحشية،
وقصيرة أيضاً-
وبعد كل هذا الوقت ما زلت تشعرينَ بالصدمة
حين تسمعينَ بحصول أمر رهيب،
تقفينَ أمامه عاجزة حتى عن البكاء،
تدركينَ في تلك اللحظات أن البراءة،
التي كنت حسبتها اختفت من زمان،
ما زالت موجودة،
وأنك في مكان ما تحت سخريتك
ما زلت متشبثة بالأمل.
لكن هذا الأمل يتحطّم كلياً عندئذ،
أو هكذا تحسبين،
ويكونُ عليك المضي قدماً وأنت مرعوبة
من أنه هناك المزيد لتعرفيه،
وأنك ستعرفينه يوماً ما.
هكذا يعملُ العالم
نعرفُ أن القبيحَ يكره الجميل،
وأن جميعَ الخاسرينَ يحترقونُ غيظاً
وهم يحتسونَ قهوة سيئة المذاق
تحت ضوء فلورسنتي رخيص
في مطعم للوجبات السريعة.
نعرفُ أن كراسي المقعدين تكرهُ الأحذية،
وأن العقاقيرَ الطبيةَ تحسدُ الفيتامينات،
ولهذا السبب تجتمعُ أحياناً
علبة كاملة من الحبوب المنومة
وتندفعُ كموجة داخل حلق أحدهم
لكي تغرق في محيط معدته الفاسدة.
ودعونا الآن لا نأتي على ذكر الفقراء
ما دام أحدٌ ما عاد يذكرهم.
هكذا يعملُ العالم –
الحزين ضد السعيد
والغبيّ ضد الجميع
وخصوصاً ضدّ نفسه.
لذا لا تزعم السرور
حين يحالف الحظ أصدقاءك القدامى
في الحبّ أو العمل،
بينما ما زلت تكابد العيش
ككركند في مغسلة مطعم.
هيا اعترف أنك ترغب
في ضربهم حتى الموت لو استطعت.
لكنك عاجز، تقرعُ عبثاً على زجاج شفّاف
لا يسعكَ اختراقه.
إنهم يفتحون زجاجات الشمبانيا احتفالاً
ناسينَ أمرك تماماً،
مثلما نسيتَ كم كتفاً تسلّقتَ
حتى تصلَ إلى هنا،
عيناكَ السوداوان تلتمعان،
أطرافك البطيئة تعمل
بكآبة وثبات.
أمةٌ واحدةٌ تحتَ السماء
ألا تشعر بالرغبة في التخلص
من بعض أعضاء جسدك
التي تثيرُ فيك القرف؟
ألا ترغب مثلاً في التخلص
من مؤخرتك أو فخذيك،
أو من نصف أنفك،
حتى يبدو شكلك صحيحاً؟
وأولئك الأشخاص الذين لا يفهون دعاباتك
أو مراجعك الثقافية،
أعني حين تقتبس جملة
من مسرحية “عربة تدعى الرغبة”
تتناسب والموقف تماماً
ويروح جليسك ينظر إليك ببلاهة مطلقة،
أفلا ترغب عندئذ في خنقه؟
أفلا ترغب في أن تمسك ربطة عنقه –
والأناس الذين يرتدون ربطات العنق
يستحقونَ مثل هذا المصير –
وتلفها حول رقبته
مثلما يشدّ مدمن على المخدرات
الأنبوب المطاطيّ حول ذراعه؟
وعلى ذكر المدمنين، ألا يمكننا التخلص منهم أيضاً؟
أن نحقنهم بالكامل بذلك الهيروين المكسيكي الملوث
الذي يلتهم اللحم؟
وأولئك السود والإيطاليون والآسيويون
والشقراوات الطبيعيات،
ألن يكون من الأفضل أن نجمعهم
ونشحنهم إلى مكان ما مثل تكساس
ونسوّرهم بسياج كهربائي،
وإياك وأن تقول لي إن قرداً في مختبر ما
أهمّ من كائن بشري،
لأنني في هذه الحالة سأرغب في أن أبرحك ضرباً.
أيها السائقون المتعبون على الطريق السريع
أعرف أننا نتفق على هذه النقطة:
أولئك الذين يبدّلون الطريق فجأة
الذين يحبون الالتصاق بسيارات الآخرين،
الذين يشعرون أنهم في سباق الفورمولا،
ألا ينبغي وضعهم في صف واحد
وإعدامهم بالرصاص؟
وبمناسبة الإعدام
كم عملية إعدام تمّت مؤخراً؟
بالتأكيد ليس ما فيه الكفاية.
لدينا مشكلات في هذا البلد، أؤكد لكم.
إذا ما كدّرتك عينك اليمنى
تعرف ما يتوجّب عليك فعله.
وعينك اليسرى تعرف أيضاً.
فتاة سيئة
إنها الفتاة التي تنام طوال اليوم
في حجرة خلف دماغك.
تصحو على صوت فلينة تفرقع
أو حبة زيتون تسقط في كأس “جين”.
إنها أجمل منك
وفي هذه اللحظات تتحمّلين ترّهاتها
تجلسين بصمت وتشربين
عندما ترغب في الوقوف عارية على حافة الكأس،
ثم الغوص إلى عمقه والنظر إلى الأعلى
مذهولة كيف يضطرب العالم ثم يصفو من جديد.
لن تسمحي لها بذلك.
لقد حبستها مع عطورها ورواياتها الرخيصة
وحاجتها العميقة إلى الوقوع في المشكلات.
إنها من يناديك من ثقب المفتاح،
من تتسلّل من النافذة،
ممزّقة فستانها الوردي.
لا يمكنك أن تخمني إلى أين هي ذاهبة
أو مع من ستستيقظين
حين تصحين أخيراً،
شاعرة أن رأسك يخفق كالقلب،
هي التي تخشينها،
التي تتحداك المضي قدماً والاختفاء كلياً.
ليس أنت من يراها الفتيان
تلتفت نحوهم وتطفئ الضوء.
أنت مهملة الآن في الزاوية.
لكنها تحبك الآن.
إنها الفتاة المختارة.
أفلام الرعب
غيوم هذا اليوم ترسم أشكالاً مخيفة،
وأظلّ أتوقّع ظهور “سايكلوبات”
في خط الأفق
مثلما تظهر في فيلم رعب بالأبيض والأسود
من الدرجة الثانية،
وتقطع المحيطات بخطوات واسعة
وتجرّني من مطبخي
إلى الكهف العميق الذي ومضت صورته
في دماغي الفتيّ ذات يوم سبت
في سينما “بارونيت” حيث جلستُ بلا حول
بين أخوي الأكبرين، مقطوعة الأنفاس
من شدة الرعب ــــ
ذاك الكهف،
مهاد العظام البشريّة المكومة عند مدخله،
يمكنني اشتمام نتانتها بوضوح
مثلما أشتم دهن لحم الخنزير عند الإفطار.
هذا ما تشعرين به عندما تفقدينه،
لا أقصد عقلك،
بل كلّ ما يجعلك تنهضين صباحاً
وتغادرين البيت حقّاً.
في تلك الأيّام حين ترين الموت بزيه الأسود
يجوب حيّك بشاحنته المحمّلة بالألواح والرزم.
تفتحين دفتر مواعيدك
وتحدّقين في موعد كتبته على عجل قبل أسبوع،
محاولة إقناع نفسك
أن اليوم موجود مع اقتناعك بعكس ذلك،
مفكّرة في صوت صديقتك
على المجيب الآلي: “لستُ هنا”
صبيحة جنازتها،
ملأت الاتصالات الشريط
والبريد ظلّ يصل،
ولنواجه الأمر، ليس من سلوان
أما الأمان فأتذكّر حين كنت أرجع إلى البيت
بعد مشاهدة أفلام مصاصي الدماء،
وأظلّ مستيقظة طوال الليل،
متخشّبة في سريري،
خائفة من الذهاب للتبوّل لأن الأموات الأحياء
ينتظرونني تحت السرير؛
إذا ما تجرّأت على وضع
رجلي في الهواء العاري
فسيجرّونني من ركبتي ويسحبونني إلى الأسفل.
وقال لي والداي:
ليس من شيء هناك،
وإنني حين أكبر
سأعرف الأشياء بصورة أفضل،
والآن ماتا، وكبرت حقاً،
وبتّ أعرف الأشياء
بصورة أفضل.
الجسدُ والروح
أين هي الروح بحسبك؟
أتحسبها أشبه بحقيبة جلدية صغيرة،
من النوع الذي يتّسع لشيء واحد:
لوح شوكولا، حساء، وعاء صغير؟
أتتكوّر هناك، وراء القلب؟
مطويّة بحذر بين الأضلع؟
أتلتفّ حول الخصيتين،
أنديّة هي كرَحم،
وهل هي قابلة للتمزّق؟
الجسد ليس بيتاً.
لكن إذا كان بيتاً
فهل تستيقظ الروح متأخرّة في المطبخ، مؤرّقة،
تقف قبالة الثلاجة المفتوحة،
هل تتعب من التلفزيون،
ومن أفكارها الخاصة؟
ليس للجسد أفكار.
الجسد يمتص الحب كمنديل ورقي
ويبقى وسخاً.
الجسد يطلق بعض المخدّر،
بعض العرق والدموع ـــ
أحياناً يصير الجسد
ساكناً جدّاً
بحيث إنه يسمع الروح،
تخرمشُ كشيء عالق
داخل الجدران
فتحاول الخروج،
مسعورة.
لويز غليك
وعاء البورسلان
لا يصلح للاستعمال:
على مقعد من العشب،
جسد امرأة مشابه،
لا أستطيع في الضوء
رؤية ما فعله الوقت بها.
تسقط بضع أوراق شجر.
وتفرّق الريح العشب الطويل،
مكونة ممراً لا يفضي.
واليد ترتفع بعفوية
تتحرّك على وجهها
ضائعة كلياً…
العشب يتمايل،
كأنما الحركة
من مظاهر الاسترخاء.
أبيض رمادي على أخضر.
يد من البورسلان
في العشب.
إخلاصاً للجوع
1. من الضواحي
يعبرون الفناء
وعند الباب الخلفي
تسرّ الأم إذ ترى
كم هما متشابهان، الأب والابنة…
أعرف شيئاً عن ذاك الوقت.
البنت الصغيرة تلوّح، متعمدة،
بذراعيها، ضاحكة
ضحكتها الصارخة:
ينبغي أن يبقى سراً، ذلك الصوت.
يعني أنها أدركت
أنه لا يلمسها أبداً.
إنها طفلة؛ يمكنه لمسها
إذا ما أراد.
2. الجدة
“غالباً ما كنت أقف على النافذة…
كان جدك
شاباً وقتذاك…
ينتظر في المساء الباكر…”
هذا ما هو المعنى.
أشاهد الهيئة الصغيرة
تتبدل إلى رجل
بينما يتحرك باتجاهها،
الضوء الأخير يرن في شعره.
لا أشكّ بسعادتهما.
بوهو يهرول جوعه الشاب،
فخوراً بأنه علمها ذلك:
كانت قبلته على الأرجح
فائقة الحنان…
بالطبع، بالطبع. سوى
أنها يمكن أن تكون يده
على فمها أيضاً.
3. إيروس
أن تكون ذكراً، أن تذهب دوماً
إلى امرأة
وأن تستعاد
إلى اللحم المثقوب:
أفترض أن الذاكرة معلّقة.
والطفلة التي تدفع نفسها
إلى ذراعي أبيها
كأنها أحبته ثانياً. ولا يخبرها أحد
بما تحتاج إلى التعبير عنه.
ثمة نظرة يراها المرء،
والفم يائس على نحو ما…
لأن الرابط
لا يمكن إثباته.
4. انحراف
يبدأ بهدوء
في طفلة معينة:
الخوف من الموت،
ثم يتخذ شكل جوع تام،
لأن جسد المرأة قبر
يمتصّ كل شيء.
أتذكر،
ممدة على السرير ليلاً،
ملامسة الثديين الناعمين الناميين،
ملامسة، في الخامسة عشر،
اللحم المضطرب
الذي يسعني التضحية به
لكي تتحرّر الأطراف
من الإيناع والحيلة:
شعرت بما أشعر به الآن،
وأنا أرصف هذه الكلمات….
إنها الحاجة نفسها إلى الكمال،
الذي بالكاد يشكّل الموت
نتيجته الثانوية.
1. أشياء مقدسة
اليوم في الحقل
رأيت البراعم القاسية لشجرة “القرانيا”
ورغبت بالتقاطها،
بأن أجعلها أبدية.
هذه بداية الزهد:
الطفلة التي بلا ذات تفصح عنها،
تأتي إلى الحياة بإنكار…
وقفتُ منفردة بإنجازي هذا،
بالقدرة على تعرية الجسد السفلي،
كإله
لا يوجد في العالم الطبيعي
ما يوازي مآثره.
قطار شيكاغو
طوال الرحلة قبالتي بالكاد تحرّكوا:
السيد ألقى رأسه الحاسر على ذراع المقعد،
بينما غفا الطفل في حضن الأم.
لم يكن هنالك سوى السمّ
الذي يحلّ محلّ الهواء.
ومكثوا هكذا
كأن الشلل الذي يسبق الموت
مسمرهم هناك.
اتجهت السكة جنوباً.
رأيت في منشعب ساقيها…
ذلك القمل المتجذّر في شعر الطفل.
عيد الشكر
في كل غرفة
محاطة بفتى جنوبي ما من جامعة “يال”
كانت أختي الصغرى تغني لحناً من أحد أفلام “فلليني”
وتُتجري اتصالات هاتفية
بينما بقيتنا ينقلون حذاءها المهمل من مكان إلى آخر،
أو يجلسون ويحتسون الشراب.
درجة الحرارة في الخارج 29،
وثمة قطة شاردة على باب البيت
تبحث عما تأكله، مخربشة على مستوعب القمامة.
لم يكن من صوت آخر.
بيد أن التحضيرات للعشاء المؤاسي
تقدّمت شيئاً فشيئاً باتحاه الموقد.
كانت أمي تحمل أسياخ الشواء
ورأيت تجاعيد جلدها
كأنما فاتها شبابها،
بينما قطع البصل
غشاوة من الثلج
على الموت الهاجم.
سيلفيا بلاث
الفطر
بين ليلة وضحاها،
شديدة البياض،
شديدة الكتمان،
شديدة الهدوء
تتشبّث أصابع أقدامنا
وأنوفنا
بالتربة،
تستنشق الهواء.
لا أحد يرانا،
أو يوقفنا، أو يخوننا؛
الحبوب الصغيرة تفسح مكاناً.
قبضات ناعمة تصرّ
على سحب الإبر
والفراش المورق،
وحتى الشراشف المورقة.
مطارقنا، أذرعنا،
بلا آذان ولا عيون،
بلا أي صوت
توسّع الصدوع،
تخترق الثقوب.
نمارس حمية الماء،
حمية كسرات الظلال،
سلوكنا خفر،
نطلب القليل أو لا نطلب شيئاً.
ما أكثرنا!
ما أكثرنا!
إننا أرفف، إننا طاولات،
إننا خنوعون
إننا صالحون للأكل،
نندفع إلى الخارج
رغماً عنا.
جنسنا يتضاعف:
عند الصباح
سنرث الأرض.
أقدامنا عند الباب.
تولد ميتة
لن تعيش هذه القصائد: يا للتشخيص المحزن.
تنمو لها أصابع أقدام وأيد،
جباهها الصغيرة تنتفخ صحواً.
وإذا ما فاتها المشي كالبشر
فليس بسبب افتقارها إلى حنان الأم.
آه، لا أفهمَ ما حدث لها!
إنها سليمة الشكل والعدد وكل شيء.
تجلس بلطف في سائل التحميض!
تبتسم وتبتسم وتبتسم لي.
ومع ذلك رئتها لا تعمل
ولا قلبها ينبض.
ليست خنازير ولا أسماك حتى،
وإن كانت نشبه الخنازير والأسماك.
من الأفضل لو كانت حية، وهي كذلك.
لكنها ميتة، وأمها شبه ميتة من الذهول،
تنظر بذهول، ولا تتكلم عنها.
أنا عموديّةٌ
لكنني كنت أحبّذ لو كنت أفقية.
لست شجرة جذوري ضاربة في الأرض
أمتص الأملاح المعدنية والحب الأمومي
وتزهر وريقاتي في مارس،
ولا أنا روعة مسكبة زهور في حديقة
أستدرج نصيبي من الآهات واللون،
جاهلة أن بتلاتي تسقط عمّا قريب.
الشجرة خالدة مقارنة بي
وإكليل الزهرة ليس بعال لكنه أجمل،
وريد ديمومة الشجرة وجرأة الزهرة.
هذه الليلة في ضوء النجوم شديد الخفوت
تضوّع الأشجار والزهور عطورها المنعشة.
أمشي بينها دون أن تراني.
أحياناً أحسبني في النوم
أشبهها تماماً –
أفكار غارقة في العتمة.
يشبهني أكثر أن أستلقي
وأخوض مع السماء محادثة مفتوحة،
وسأكون مفيدة في نومي النهائي:
عندئذ قد تلمسني الأشجار مرة،
وتجد الأزهار بعض الوقت لي.
مرآة
فضيّة ودقيقة أنا ولا أعرف التحامل.
كل ما أراه أبتلعه كما هو،
دونما تأثر بحب أو كراهية.
لست فظة بل صادقة –
عين إله صغير مربّعة.
معظم الوقت أتأمل الجدار المقابل.
إنه زهري مبقّع، ولكثرة ما نظرت إليه
بتّ أحسبه بعضاً من قلبي. لكنني لا أراه غلا متقطعاً.
الظلمة والوجوه تفصل بيننا.
ها أنا الآن بحيرة. ثمة امرأة تنحني فوقي،
باحثة في أعماقي عن ماهيتها الحقيقية.
ثم تلتفت إلى أولئك الكذّابين، إلى الشموع أو القمر.
أراها من جديد وأعكس صورتها بصدق.
تكافئني بالدموع وبرعشة اليدين.
إنني مهمّة بنظرها، ولذلك تكثر من زيارتي.
كل صباح يحلّ وجهها محلّ الظلمة.
وفيّ أغرقت فتاة يافعة، وفيّ تنهض عجوز نحوها،
يوماً بعد يوم، مثل سمكة رهيبة.
رسالة حب
ليس سهلاً أن أصف التغيير الذي أحدثته.
إذا كنتُ حيّة الآن، فمن قبل كنت ميتة.
ومع ذلك، مثل حجر، لم يزعجني ذلك،
أبقتني العادة في مكاني.
لم تحركني قيد أنملة، لا،
ولا تركتني أرفع عيني الجرداء الصغيرة
نحو السماء ثانية، بلا أمل، بالطبع،
لإدراك الزرقة أو النجوم.
لم يكن الأمر كذلك. نمتُ:
أفعى مقنّعة بين صخور سوداء
في رحم الشتاء الأبيض…
مثل جيراني الذين لا يسرّهم
مشهد المليون وجنة رائعة النحت
التي تشعل كل هنيهة لكي تذيب
وجنتي التي من البازلت. انكبوا على الدموع،
ملائكة تبكى على أمزجة كئيبة،
لكنهم لم يقنعوني. تلك الدموع تجلّدت.
كل رأس ميت اتخذ قناعاً من جليد.
واستأنفت نومي كإصبع معقوف.
أول ما رأيته كان هواء صرفاً
والقطرات المقفلة تنهض في ندى شفاف كالأرواح.
حجارة كثيرة انتشرت كثيفة متجمّدة في كل مكان.
لم أعرف ماذا أفعل بها.
تلألأت، مكسوة بالزجاج، وتفتّحت
لكي أسكب نفسي كالسائل
عند قدم الطائر وساق النبتة.
لم أخدع. عرفتك فوراً.
التمعت الشجرة والحجر بغير ظلال.
صرت بطول إصبع صافية كالزجاج.
بدأت أتبرعم مثل غصين في مارس:
ذراع ورجل، ذراع ورجل.
من حجر إلى غيمة، هكذا ارتفعت.
الآن أشبه نوعاً من الإلهة
أطوف الهواء في قميص روحي
نقية كلوح جليد. إنها نعمة.
الرقصات الليلية
ابتسامة سقطت على العشب.
لن تُسترد!.
وكيف ستفقد رقصاتك الليلية
السيطرة على نفسها. في الرياضيات؟
بالتأكيد قفزات وتحليقات نقية
تطوف العالم إلى الأبد،
ولن أمكث
فارغة من الجمال،
هبة نفسك الصغير، العشب المبلل
يفوح بنومك، سوسن، سوسن.
لهب لا يحمل نسباً.
طيات باردة من الأنا، من الزنبق
والنمر، يزيّن نفسه…
بقع وغطاء من البتلات الحارة.
يا للمسافة
التي على المذنّبات قطعها،
يا للبرد، يا للنسيان.
لذا إيماءاتك تتقشّر دافئة وبشرية…
ثم يتقشّر وينزف
ضوؤها الزهري في ذاكرة الفردوس الضائعة.
لماذا أعطيت هذه المصابيح، هذه الكواكب
التي كالنعم، كالرقاقات
تسقط بيضاء
على عيني، على شفتي، وشعري،
تلامس وتذوب
في لا مكان.
تيودور رتكي
القرار
1.
ما الذي يقلق الروح أكثر من اللا مرئي؟
الفرار من الرب أطول سباق على الإطلاق.
ظلّ طائر يطاردني في شبابي…
إلهة القمر تنسحب ببطء من أغنيتها،
ولا أستطيع أن أخرج ذلك الصوت من رأسي،
الصوت الناعس لأوراق الشجر في الريح الخفيفة.
2.
السقوط والهبوط سواء!
خطّ أفقي رفيعاً يستحيل!
أيهما الطريق؟ أصرخ بالأسود المرعب،
الظل المتنقّل، الفلذات التي على ظهري.
أيهما الطريق؟ أسأل، وأستدير لأعود،
بينما يلتفت رجل قبالتي – يصير ثلجاً.
كتمانها
لو أمكنني فقط أن أرسل له
كمّاً واحداً وفيه يدي
وحيدة بغير دماء
لكي يقبّلها أو يربّتها
مثلما سيفعل أو لن يفعل…
لكن أبداً ليس نظرات عيني،
ولا قلب أفكاري،
ولا الروح التي تسكن جسدي،
ولا شفتي، ولا نهديّ، ولا ساقي،
ولا كلّ ما يرتعش فيّ
حين تتنهّد الريح.
كلماته
سمعت ما قاله رجل يحتضر
لعائلته المحتشدة حوله،
“روحي معلقة في الخارج حتى تجفّ
مثل جلد طازج مملّح؛
أشكّ في أنني سأستعملها ثانية.
ما تمّ لم يأت بعد؛
اللحم يهجر العظام،
لكن قبلة تفتّح الزهرة؛
أعلم، مثلما يعلم المحتضر،
الأبدية الآن.
“الرجل يرى، وهو يحتضر،
احتمالات الموت،
قلبي يتأرجح مع العالم،
وقد صرت ذلك الشيء الأخير:
رجل يتعلّم الغناء”.
ذكرى
1.
في عالم الأحلام البطيء
نتنفّس في آن معاً،
الخارج يموت في الداخل،
وتعرف كل ماهيّتي.
2.
تستدير كأنما لتذهب
نصف طائر، نصف حيوان،
الريح تموت على الهضبة
الحب كل ما أعرف.
3.
ظبية تشرب عند نهر
ظبية ووليدها.
حين أتبعهما
يستحيل العشب حجراً.
أوامر اليوم
أيتها اليدان الصلبتان المعروقتان
أحسنا أداء الدور
لأن اللامبالاة قد تخمد
فتيل ما يشتعل من رغبة؛
العاشق المتنهّد أسير الجسد،
أنامله الخرقاء تجرح
غلالة الروح الرقيقة.
أيتها القدمان احملا العظام الرفيعة
فوق مرقى البراءة،
اجتنبا نهر الكراهية الهائج،
السهل الخطر المغمور بالطوفان
حيث يحوم الأفعى والنسر
ومتسللتان كطائر الكركي
فلتجتازا المستنقعات إلى العشب.
أيتها العينان تحدقّان بسواكما
ممن نظراتهما الشبحية
تكشف أماً خرقاء؛
تجنبا تلك الحواجز
واكتشفا العناية
بين الأنفاس المسمومة
اقلبا الدم القديم رأساً على عقب.
عن الموت
البدعة تضطجع في جمجمة
لم تعد سريعة في الضوء،
القفير الذي دندن في كل خلية
خُتم الآن بإحكام كالعسل.
فكره مغلول، قوس مركب الحركة
رسا على صخرة؛
الدقائق تنفجر أعلى الحاجب
الغافل عن الصدمة.
صلاة
إذا ما كنتُ سأخسر شيئاً من حواسي الخمس
فلتدعني يا ربّ أختار
أياً منها أستبقي
قبل أن يغمر النسيان عقلي.
اللسان ميت منذ أجيال،
أنفي يشوّه وجهاً وسيماً؛
ولأنهما تصغيان إلى رغبات الجسد
فأذناي ليستا إلا أذني الشيطان؛
وبعضهم يجزم بأن العين
آلة الشهوة الفاسقة،
الأكثر ضراوة من اليد الوضيعة في الفاحشة
وهذا غير صحيح
غوايتها رقيقة، وليست بأعنف
من استعارة.
العين، في واقع الأمر،
هي المحرّض على أكثر الحب الأفلاطوني عفّة:
الشفاه، الصدر، والفخذ
لا يسعها امتلاك نعمة مفردة كهذه.
إذن يا رب دع لي الحاسة الأروع
خذ اللسان والأذن – كل شيء آخر لدي –
ودع الضوء يحملني إلى القبر.
آن ساكستون
ضراوة الهجران
أحدهم يعيش في كهف
يأكل أصابع قدميه،
هذا كلّ ما أعرفه.
أحدهم صغير يعيش تحت أيكة
يضع عبوة كوكا كولا فارغة
على معدته المنتفخة الجائعة،
هذا كلّ ما أعرفه.
قرد بترت يداه
لتجربة طبية
وانتحب مخلباه.
هذا كلّ ما أعرفه.
أعرف أن المسألة كلها
تتعلّق بالأيدي.
من العذوبة الباكية للمس
يأتي الحب
من البيوت الكثيرة تأتي الأيدي
قبل هجران المدينة،
من الحانات والمتاجر،
يخرج صف رفيع من النمل.
لقد لفظت في الخارج هناك
تحت النجوم الجافة
بلا حذاء ولا حزام
واتصلت بشركة الإنقاذ
ذلك الخط الساخن القديم
ولم يجبني أحد.
ألمس شفتيّ
ألمس منخري، كتفي، نهدي،
سرتي، معدتي، مؤخرتي، ركبتي،
كاحلي، ألمسها كلها.
يضحكني
أن أرى امرأة على هذه الحال.
يضحكني أن أرى أيدي أمريكا و”نيويورك سيتي”
مبتورة
وليس من يردّ على الهاتف.
المسرحية
إنني الممثلة الوحيدة.
يصعب على امرأة
أن تمثّل مسرحية كاملة.
المسرحية هي حياتي،
فصلي الوحيد.
ركضي وراء الأيدي
وعجزي عن اللحاق بها.
(الأيدي غير مرئية
لأنها خارج الخشبة…)
وكل ما أفعله على الخشبة هو الركض،
مطاردة شيء ما
دون أن أصل أبداً.
فجأة أتوقف عن العدو.
(هذا يغيّر الحبكة قليلاً)
ألقي خطباً، مئات الخطب،
كلها صلوات، كلها مناجاة،
أقول أشياء عبثية من قبيل:
لا يجب أن يتعارك البيض مع الحجارة
أو أبق ذراعك المسكورة داخل كمّك
أو إنني أقف منتصبة
لكن كتفي مائل.
أمور من هذا القبيل
وصرخات استهجان كثيرة، كثيرة جداً.
ومع ذلك أصل إلى الأسطر الأخيرة:
أن تكون بلا رب أن تكون أفعى
تريد ابتلاع فيل.
تسدل الستارة.
يهرع الجمهور خارجاً.
كان أداء سيئاً.
هذا لأنني الممثلة الوحيدة
وقلة من البشر تشكّل حيواتهم
مسرحية مثيرة للاهتمام،
ألا توافقني على ذلك؟
أي شيء هو هذا؟
قبل أن يدخل
راقبته من نافذة مطبخي،
رأيته ينتفخ مثل كرة جديدة،
رأيته يسقط ثم ينقسم
مثل شيء أعرف أنني أعرفه…
إجّاصة مقطّعة أو قمر مشطور إلى نصفين،
أو أطباقاً بيضاء مدورة تطفو في لا مكان
أو يدان سمينتان تلوّحان في هواء الصيف
حتى تتضامّا كقبضة أو ركبة.
بعد ذلك جاء إلى بابي. الآن يعيش هناك.
وبالطبع: إنه صوت ناعم، ناعم كأذن فقمة،
صوت ظلّ عالقاً بين شكل وشكل ثم عاد إليّ.
تعرف كيف ينادي الأهل أولادهم
على الشواطئ الجميلة في أي مكان، “تعالوا تعالوا”،
وكيف تغوص تحت الماء
لكي لا تسمع الصوت،
أو حين يُلمس أحدهم في ردهة البيت ليلاً:
الحفيف والجلد الذي لا تعرفه لكنك تسمعه،
اصطخاب الموج العنيد وشخير الكلب. إنه هناك
الآن، وقد أعيد من الزمن في سنوات نضجي..
الصورة التي نسيناها: الأصداف على أرجلنا
أو حركة الملعقة في الحساء. إنه حقيقي
كالشذرات في أذنيك. الصوت الذي نسرقه
هو نصف جرس.
وفي الخارج سريعاً تعبر السيارات الضواحي
وهو هناك وحقيقي.
ما هو هذا الشيء ،
هذا الشكل الغامض الذي يرسمه الهواء؟
يناديني، يناديك.
نزهة على ضوء القمر في حديقة المصحّ
شعاع شمس الصيف
يتنقّل خلل شجرة مريبة
وإن سلكت في وادي ظلال الموت
يمتصّ الهواء
ويطوف بأنظاره بحثاً عني.
العشب يتكلم
أسمع ترانيم خضراء طوال اليوم.
لن أخاف سوءاً ، لا أخاف سوءاً
أنصال العشب تمتد
وتقطع عليّ الطريق.
السماء تتشظّى.
تتدلى وتتنفس في وجهي.
في حضرة أعدائي، أعدائي
العالم مليء بالأعداء.
ليس من مكان آمن.
طحالب الجلد
كان مهماً فحسب
أن أبتسم وأكتم صوتي،
أن أضطجع قربه
وأظل هامدة لبعض الوقت،
أن ننثني على بعضنا بعضاً
كأننا حرير،
لكي لا ترانا أمي،
وأن نظلّ صامتين.
كانت الغرفة المظلمة تبتلعنا
مثل كهف أو فم
أو معدة.
كنت أحبس أنفاسي
وكان أبي هناك،
أصابعه، رأسه الضخم،
أسنانه، شعره الذي ينمو
مثل حقل أو شال.
أنام على طحلب جلده
حتى يصير الأمر غريباً.
لن تعرف شقيقاتي
أنني كنت أسقط من ذاتي
وأزعم أن الرب لن يرى
كيف كنت أحتضن أبي
كشجرة قديمة يابسة.
رأس امرأة تنتظر
إذا كنت أمرّ حقاً
بالمنتجع نفسه في الشارع نفسه
وأرى رأساً آخر ينتظر وراء النافذة العليا نفسها،
تماماً مثلما كانت تجلس على كرسيها الخشبي،
منتظرة مجيء أي أحد،
فكل شيء عندئذ يمكن أن يكون حقيقياً. كل ما أعرفه
أنها كل ليلة كانت تكتب على دفترها الجلدي
أن أحداً لم يأت. بالطبع أتذكر كيف كانت أصابعها
تمسك بأصابعي كالعقافات، مع أنني حتى الآن
لن أعترف كم مرة تجنبت المرور بالشارع
الذي عاشت فيه طويلاً كثوب بال
ونسيتنا على أي حال؛
زائرة لبّ قبلتها، منحنية
لأكرّر كل مذاق، محاولة تصفيف شعرها المستعار المزيّت
ومجبرة الحب على الاستمرار. الآن هي ميتة إلى الأبد
والدفتر الجلدي أصبح لي. اليوم أرى الرأس
يتحرّك كملاك ملعون وراء تلك النافذة العالية.
ما الذي يفعله الرأس المنتظر؟ يبدو هو نفسه.
هل سينحني إلى الأمام بينما أستدير لأعود الأدراج؟
أحسب أنني أسمعه يناديني في الأسفل
لكن أحداً لم يأت، أحداً لم يأت.
تشارلز بوكوفسكي
الآن
أن تصل إلى هنا
أن تبلغ الشيخوخة
تاركاً سنوات العمر خلفك
دون أن تكون قد التقيت
شخصاً شريراً حقاً
دون أن تكون قد التقيت
شخصاً استثنائياً حقاً
دون أن تكون قد التقيت
شخصاً طيباً حقاً
حين تبلغ الشيخوخة
وقد مرت سنوات العمر
الصباحات هي الأسوأ.
اعتراف
أنتظر الموت
كهرّ
سيقفز على السرير
أكثر ما أحزن
من أجل زوجتي
سترى هذا
الجسد
الأبيض
الهامد
ستهزه مرة
ثم ربما مرة ثانية:
“هانك!”
هانك لا يجيب.
ليس موتي ما يقلقني
بل زوجتي
حين تبقى
مع هذا الكومة
من اللاشيء.
ومع ذلك
أريدها أن تعرف
أنني طوال تلك الليالي
التي نمت بقربها
حتى مع تلك المشاحنات المجانية
كانت كلها رائعة
والكلمة الصعبة
التي لطالما خشيت قولها
يمكن أن تقال الآن:
أحبك.
صديقي الألماني
هذه الليلة
أحتسي شراب “السنغا” التايلاندي
وأستمع إلى فاغنر
أكاد لا أصدّق
أنه ليس الآن
في الطرف الآخر من الغرفة
أو عند مفترق الشارع
أو على قيد الحياة
في مكان ما
وهو كذلك
بالطبع
هذا ما تقوله أصواته
وتنميلات صغيرة
تدبّ
على
ذراعيّ الإثنين
ثم
قشعريرة
إنه هنا
الآن.
يد ميلاد سعيد
حين كان فاغنر عجوزاً
أُقيمت حفلة عيد ميلاد
على شرفه
وعُزفت معزوفتان
عشوائيتان
مفعمتان شباباً.
بعد الانتهاء سأل:
“من ألفهما؟”،
“أنت” قيل له.
“آه” أجاب،
“يبدو الأمر كما حسبته دائماً: الموت
له بالفعل
بعض المزايا”.
الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين
أظن أنها كانت حفلة رأس السنة في منزلي،
كنت واقفاً أحمل كأساً
حين اقترب مني ذاك الشاب النحيف
وكان ثملاً بعض الشيء وقال:
“هانك، لقد تعرفت بامرأة أخبرتني
إنها كانت زوجتك طوال عامين”
“حقاً؟ ما اسمها؟”
“لولا إدواردز”
“لم أسمع بها قطّ”
“آه، هيا يا رجل، لقد أخبرتني…”
“لا أعرفها يا عزيزي…”.
في الواقع لم أكن أعرفه هو،
احتسيت كأسي حتى آخر قطرة
واتجهت إلى المطبخ
وملأته ثانية
ثم نظرت حولي، بلى، هذه شقتي
لقد تعرّفت إلى المطبخ.
حفلة رأس سنة سعيدة
مرة أخرى.
يا إلهي.
خرجت لأواجه
الناس.
الهاتف
رنينه يأتي لك بالناس
أناس لا يعرفون ماذا يفعلون بأوقاتهم
أناس يتحرّقون
لأن يعدوك بحالتهم عن بعد
(مع أنهم يفضّلون
أن يكونوا معك في الغرفة نفسها
لكي يفرضوا تبطّلهم عليك بصورة أفضل).
الهاتف
صنع للحالات الطارئة فحسب.
هؤلاء البشر ليسوا حالات طارئة،
إنهم كوارث.
لم أرحّب قطّ برنين الهاتف.
“مرحباً”، أجيب بحذر،
“معك دوايت”
وتشعر بتوقهم الشديد لغزوك،
إنهم البراغيث البشرية
التي تزحف في الروح.
“أجل، ماذا هنالك؟”.
“حسناً، أنا في المدينة الليلة
وفكّرت ربما…”.
“اسمع يا دوايت، وقتي ضيق جداً،
لا أستطيع…”.
“حسناً، ربما مرة أخرى؟”.
“ربما لا”.
كل واحد منهم لديه الكثير من الأماسي
وكل أمسية مهدورة ليست إلا اعتداء صارخاً
على الحياة الوحيدة التي تملكها؛
ناهيك عن أن مثل هذه الزيارات
تخلّف مذاقاً يستمر يومين أو ثلاثة
بحسب نوعية الزائر.
صنع الهاتف
للحالات الطارئة فحسب
تطلّب الأمر مني دهراً
حتى صرت أعرف أن أقول “لا”.
الآن
لا تقلق بشأنهم،
رجاء:
سيطلبون ببساطة رقماً آخر.
قد يكون رقمك.
“مرحباً”، ستقول.
“وسيقولون: “معك دوايت”.
وعندها
تستطيع
أن تكون
روحاً
لطيفة
متفهمة.
أعظم ممثل في عصرنا
(إلى مارلون براندو)
يوماً بعد يوم يزداد سمنة،
وقد سقط كل شعره تقريباً،
إلا خصلة يربطها من الخلف
برباط مطاطي.
لديه منزل على التلال
ولديه بيت في الجزر
ولا يراه إلا حفنة من الناس.
بعضهم يعتبره أعظم ممثل في عصرنا.
أصدقاؤه قلة قليلة،
معهم يمارس هوايته المفضلة:
الأكل.
في أوقات نادرة يصل إليه أحدهم بالهاتف
غالباً لكي يعرض عليه المشاركة
في فيلم مهم.
يجيب بصوت بالغ النعومة:
“آه لا، لا أريد
المشاركة في المزيد من الأفلام…”.
“أنستطيع أن نرسل لك السيناريو؟”.
“حسناً…”.
ثم لا يسمعون صوته ثانية.
ما يفعله عادة بعد تناول الطعام
(إذا كانت الليلة باردة)
احتساء بعض الكؤوس
ومشاهدة السيناريو
يحترق في المدفأة.
أو بعد تناول الطعام
(في الليالي الدافئة)
بعد عدد من الكؤوس
يخرج السيناريوهات من الثلاجة
ويناول بعضها لأصدقائه
ويحتفظ بالبعض الآخر
ثم معاً، من شرفة البيت
يقذفونها كالأطباق الطائرة
في الوادي الفسيح تحتهم.
ثم يعاودون جميعاً الدخول
عارفين بالغريزة
أن السيناريوهات كانت سيئة
(على الأقل هو يستشعر ذلك
وهم يقبلونه)
إنه عالم حقيقي رائع هناك:
عالم تحقق بعرق الجبين،
عالم كاف،
بالكاد تعنيه المتغيرات.
عالم فيه متسع من الوقت:
للأكل،
الشرب،
وانتظار الموت
كسائر البشر.
إلى العتمة وخارجها
زوجتي تحب دور السينما، الفشار والمشروبات الغازية،
الاستقرار على المقاعد، تجد لذة طفولية في ذلك
وأنا سعيد من أجلها، لكنني حقاً، شخصياً، لابدّ من
أنني جئت من كوكب آخر، لابدّ من أنني كنت خلداً
في حياة أخرى، شيئاً يحفر جحراً ويختبئ وحيداً:
الآخرون، المحتشدون على مقاعدهم، قريباً وبعيداً مني،
يمنحونني شعوراً مقيتاً؛ هذا غباء ربما، لكنه يحدث،
ثم هناك العتمة ثم الوجوه العملاقة، والأجساد المتنقلة على الشاشة، هم يتكلمون ونحن نصغي.
بين مائة فيلم هنالك واحد معقول، أو جميل،
وتسعة وثمانون فيلم بالغ السوء.
معظم الأفلام تبدأ بطريقة سيئة
وتزداد سوءاً باضطراد؛
إذا استطعت تصديق تصرفات الشخصيات وطريقة كلامها
فقد تصدق حتى أن الفشار الذي تمضغه
ينطوي على معنى ما.
(حسناً، من المحتمل أن الناس يشاهدون الكثير
من الأفلام بحيث أنهم حين يشاهدون أخيراً
فيلماً جيداً يحسبونه عظيماً. جائزة الأكاديمية تعني
أنك لست غبياً بقدر ابن عمك).
ينتهي الفيلم ونخرج إلى الشارع،
ونتجه إلى السيارة. “حسناً”، تقول زوجتي:
ليس جيداً بقدر ما قيل عنه”.
“لا”، أجيب، “ليس بجيد”.
“لكن فيه بعض الأدوار الجيدة”، ترد.
“أجل”، أجيب.
نصل إلى السيارة،
وأتجه خارج هذه الناحية من المدينة؛
نذهب في جولة ليليلة،
يبدو الليل جيداً.
“أتشعر بالجوع؟”، تسألني.
“أجل، وأنت؟”.
نقف عند إشارة سير؛ أراقب الضوء الأحمر؛
أستطيع التهام الضوء الأحمر أو أي شيء،
أي شيء أملأ به هذا الفراغ؛ ملايين الدولارات تنفق
على شيء أفظع من الحياة الفعلية
التي يعيشها معظمنا؛ لا ينبغي أن يدفع المرء قطّ
تذكرة دخول إلى الجحيم.
يتبدّل الضوء ونهرب،
إلى الأمام.
دنيس ليفرتوف
يأس
بينما كنا نزور ضريح دافيد
رأيت على مسافة قصيرة
امرأة تهرع نحو ضريح آخر
مادة يديها، متعثرة في عجالتها،
ثم واقعة
على الشاهدة التي تهمّ إليها
ثم تمدّدت فوق الضريح، باكية،
وكان بكاؤها عويلاً.
كانت أنيقة الملبس في معطف شاحب
ولم تبد شابة ولا عجوزاً.
لم أستطع رؤية وجهها، وبدا
أن أصدقائي لم يدروا بوجودها.
لم أقل شيئاً لكي لا أحزنهم.
لكنها لم تكن طيفاً.
وحين سرنا عائدين
بصمت إلى سيارتنا
نظرت خلسة إلى الوراء ورأيتها تنهض
عن الضريح وتهدئ نفسها وتبدأ بالتراجع
ببطء عن الضريح.
على عكس دافيد الذي يعيش
في حيواتنا، بدا أن أياً كان
من تبكي عليه يمكث
هناك في الحقل، تحت الحجر.
بدا أن المرأة تعتقد
أن من تحبه يسمعها،
يسمع نحيبها،
يرى عري عذابها،
ويأبى أن يتكلم.
القلب
في أية لحظة
ينكسر القلب لأتفه الأسباب…
الفقراء ينهضون في أفضل أحوالهم،
الأثرياء يحاولون، يحاولون الإرضاء…
كلّ لمسة وينشأ صدع جديد،
يا لها من شبكة.
تذكّرني بطبق صيني قديم
تُرك طويلاً في الفرن.
إذا على العضلة الدامية يضخّ
اسمه في القفص الصدري
كل نقرة قدر تنقش نفسها،
من سيعيش طويلاً؟
لكن هذا يعزّز الاستجابة السريعة،
دونما إدراك للمطلق.
كوارث التاريخ تثقله
عذابات الضمير تضغط على جوانبه
لكنها لا تشقّه ولا تفتته إلى غبار
ماذا تحت الجلد المتصدّع؟
أن تطلب قمراً (1)
ليس القمر. بل زهرة
على الضفة الأخرى من المياه.
المياه تندفع وتحمل
شجرة كاملة من شعرها،
تحمل حظيرة، جسراً. الزهرة
تغني على الضفة البعيدة.
ليست زهرة. بل طائراً يصدح،
مختبئاً بين أكثر الأشجار ظلمة،
موسيقى فوق المياه، تصنع صمتاً
من الحقول السمراء لعباءة النهر.
القمر. شاب يمشي
تحت الأشجار.
وثمة قناديل مضاءة
بين أوراق الشجر.
رقيق، حكيم، مرح
وجهه يشرق بضوئه الخاص
أراه على الضفة الأخرى.
مهرّج تنبعث الموسيقى عميقة من أجراسه،
نغمة أسف،
أرقص على وقعها على الضفة الأخرى.
أن تطلب قمراً (2)
ليس القمر. أن تكونين رأساً برونزياً
يسكنه إله.
جذعاً من الغرانيت
أهمل في العراء عشرة آلاف عام،
تعشقه الغيمات العابرة.
ظلالها تصبغه بضربات من أزرق الغبار.
تسلم نفسها له في مطر لانهائي.
أن تكونين غيمة. متخمة بالتجوال، تمسك
روعة التغيير من الداخل، روعة الذوبان،
المطر.
أن تستلقي في أحلام
شاب
شعره
بلون شجر الماهاغوني.
ألا تملك
ألا تملك، لكن أن تكون.
قلب الجرو الأسود،
آه، أن تضطجع هناك كبذرة.
أن تصبح المعشوق.
بينما ينتهي العالم، أن تدخل
النغمة الأخيرة من موسيقاه.
القناع
“إذ ثمة مغامرة أكبر
في السير عارياً”
و. ب. ييتس
عارية مشيت
منذ البداية
مستنشقة حياتي
متنفّسة
القصائد،
فخورة
ببراءتي.
لكن من غيوم الأغنيات صُنعت أنفاسي
في الصقيع
نبتت عباءة
بيضاء
حيث هنا كلمة
هنالك أخرى
تتجمّد، لمّاعة، ثقيلة
كحجر.
لم أقصد قناعاً،
كأنما كان الجليد
غلالة وجهي.
عينان شاخصتان،
صمت متلهّف في صلب الأغنية.
الحياة من حولنا
شجرات الحور والسنديان مستيقظة
طوال الليل.
وفي جميع تقلّبات الطقس طوال العام.
ثمة شيء
غير محدّد.
غروب الأمس،
وقد أشرف أغسطس على الانتهاء،
ظلّ يتبدّل ببطء حتى الفجر.
الأصوات البشرية
كانت مكتومة خلف الستائر.
وليس من بشريّ رأى الليل في الحديقة،
وهو يتسلّل أزرق نحو الصباح.
وحدها الأشجار الضريرة،
بغير خلايا دماغية،
عاشته
وعرفته بالكامل.
معرفة الطريق
يمامة الغابة نطقت
ببطء
تلك الكلمات التي عليها
أن تنطقها،
وبنعومة.
لكنها فرّت
بجسارة،
وطارت سريعاً.
انتظار
الشجيرات على جانب الطريق تنتظر، تنتظر.
وليس من أحد
لملاقاتها.
ذهبية في غيمة غبار من شعاع الغروب
أمرّ أيضاً.
شمس، قمر، وحجارة
كنت متشوقاً للرحيل، أن أسلك درب الجبال الجرداء،
المعزولة قبالتي، وأسير بلا توقف، من دون أن أرى
شيئاً سوى الشمس والقمر والحجارة”
نيكوس كازنتزاكس
شمس
قمر
وحجارة
لكن أين لنا أن نجد
المياه؟
الشمس
ترفع كل الأشياء عالياً وخارجاً
تنشب
سيف الظمأ في الفم.
القمر
يملأ الرحم جليداً.
الحجارة: أسلحة
تحمل الدفء إلى الليل،
والندى إلى النهار، وتمزق
جلد القدم المتعثرة.
وقد ولدنا لهذه النهاية الوحيدة:
أن نظمأ ونكبر
أن نرتعش أن نحلم
في الندى المتباطئ، في الدفء المتواني
إلى بحث متعثر.
لكن، آه،
أين لنا أن نجد الينابيع؟
فلورنس أنطوني (آي)
حظّ
بعد اكتشاف اختبارات نووية تجريها الحكومة الأمريكية على مواطنين أمريكيين.
ريح مريضة في حقيبة “سامسونيت”
كانت تعبر وايت ساندز، نيو مكسيكو،
في شباط ،1952
حين كنا أنا وأمي وأختي الصغرى
في طريقنا إلى تكسون
في “فورت رايلي”، كنساس.
كنا في عطلة
لم يخمّن أحد أنها ستأخذ أبي إلى جناح السرطان.
الوقائع القاسية لا يمكن استعادتها
أو إعادة ترتيبها كقطع “سكرابل”
لتركيب كلمة أخرى غير نهائية.
قال أبي: “افتحوا النوافذ
دعوا الهواء المنعش يدخل. لا تقولا لي
أيتها الفتاتان إنكما تريدان دخول الحمام ثانية.
سنتوقف عند أول محطة وقود
ورجاء يا ستيلا
لا تأخذي المزيد من المناديل أو الصابون.
لا نريد أن نبدو سيئين كزنوج.
لن يكون هذا جيداً للعرق”.
قالت أمي: “سيتهموننا بالسرقة في أية حال”،
ومضت السيارة بنا في الأصيل الرمادي،
كان الرمل أبيض كفستان عروس.
والسماء عريس يعانقها.
كان مصير اجتماعهما إلى كارثة، لكن من كان ليعرف،
حين توقفنا وخرجت أمي
وأحضرت قبضة رمل
لتحفظها مع بقية التذكارات
التي تحضرها معها إلى البيت منتصرة؟
كنت أعتمر قبعتي “الراي روجرز” الكاوبوي الحمراء،
قميصي الوسترن، جزمة الكاوبوي، وبنطال “ليفيز”،
وسحبت مسدسي من غمده وأطلقت الرصاص
على الشمس التي تذوي،
فيما عصفت الريح على الأوتوستراد
على البلدة التالية التي بلا حول ولا توقّع،
منذ أيام عثرت على مرآة
ابتاعتها أمي منذ زمن بعيد
وحين نظرت فيها
رأيتنا في سيارتنا “فورد” القديمة
ذات الباب المربوط بسلك.
وقتئذ كأن أبي مؤمناً بالمسيح وبالديمقراطية.
لم يكن يخشى ما لا يستطيع رؤيته وتذوقه أو الإحساس به
حين وضع يده على المقود
وقاد السيارة إلى شتائه النووي الخاص.
دروس بعد الظهر مع قاتل مأجور
ما أفعله هو سرّنا.
صه،إذا أفشيتَ السرّ
فسأدفنه عميقاً
أعمق من هذا.
كل شيء على ما يرام.
كلّ شيء رائع
ما دمت تحتفظ بالسرّ.
لا تدعه…
افتح فمك.
افتحه أكثر.
إذا كنتَ ستبكي…
لن تقدر أمك على المساعدة.
ولا أبوك.
الرجل رجل.
وأحياناً لا يكون شيئاً.
ستتعلّم مع الوقت.
ستتعلّم مثلما تعلّمت.
تعرف ما تعرفه.
أليس كذلك أيها الفتى؟
ذلك الوقت في جيرسي
حين وضعت بندقيتي بهدوء
وتنحيت من درب الزبائن،
نظرت أمامي،
صعدت إلى الصيف،
ركبت السيارة
التي تركتها شغّالة.
أتتابع ما أقول حتى الآن؟
هم..م..م
والآن ارفع سروالك
واغرب عن نظري.
إذا كان عليّ أن أرقص
فسأرقص منفرداً
حسنا؟
أمر آخر.
هناك دائما احتمال،
احتمال أن القاتل المأجور يمكن…
لا، لا تفكّر بهذا.
امضِ فحسب.
اسمع، كيف حال أخيك
أحضره معك المرّة القادمة.
لست صغيراً البتة
على تعلّم الأشياء.
أعدك.
ستعرف كلّ ما أعرفه.
لطالما قلت إنه ليس عاراً؛
إنها جريمة
والحمد لله أن شخصاً آخر
يدفع الثمن.
هذه المرّة.
لبابارازي
أقف على الحافة
خارج غرفة نومك في الفندق،
حين ألمح عشيقك الحالي
يميل فوقك على السرير
ويضع حبة كرز
يحملها بين أسنانه
أعلى شعرك البني الغامق الكثيف.
أنت شقراء بنظر معجبيك
لكنني أعرف حيث لست كذلك.
للحظة، أشعر بالحرارة،
وأنا أراقبه، لكن ينبغي أن أكون بارداً،
أحصل على اللقطة،
وأتسلل إلى منزل آخر.
هيا حبيبتي، هيا.
يجب أن أطارد وغداً آخر
يحسب أن دوراً تلفزيونياً
يجعله أفضل من أن يُفتضح
أمام الجمهور النهم
الذي يريد أن يعرف
كل أسراره الصغيرة القذرة،
أو مجرد نوع الحساء الذي يحب.
الكحول، الإجهاض، الطلاق،
الزواج، عمليات شدّ الوجه،
حفلات المخدرات الجماعية،
علاقات اللواط والسحاق وثنائية الجنس.
رأيت هذا كلّه
وأنا هنا الآن من أجلك،
صديقاً لا عدواً،
مختلس نظر، أو نازي “تابلويد”،
أتسلل إلى يختك لأصورك
في آخر لحظاتك المحرجة.
فكّري بي كمحطة عبور
وبالكاميرا كقسّ الاعتراف،
الذي يحلّك
من جرائمك الأصغر
من الجرائم التي أعرف أنك مذنبة بها.
يا عاهرة الميديا، لم اطلب منك أعذاراً،
طلبت منك المزيد
وأعرف أنك ستمنحينني المزيد
قبل أن يملّك الجمهور الجمهور
وينتقل إلى النجم التالي،
لكن حتى عندئذ وبين الحين والآخر
سأظل أكمن لك
وأبعث الرسالة
من أرض حياتك المهنية الذاوية
أنك تتعثرين
في فضائك الأعلى
كما الحال دائماً،
لكن الآن الصوت الوحيد الذي تسمعينه
وأنت تهبطين ثانية
هو صوت الكاميرا
وليس التصفيق والاستحسان.
لا أريد الحقيقة،
أريد الأكاذيب،
لذا احتفظي بهذا المظهر،
قولي شيئا فاجراً.
لا تخجلي.
رواندا
كان جارنا يزور كوخنا عادة
محضراً معه بطيخاً لذيذاً إلى درجة
إنني كنت أفكر ألا آكله،
لأنني سأموت عندها
وأطارد كشبح عائلتي
ببزر أسود قاس بدلاً من العينين.
ذات يوم أحضر معه عمه وصديقيه
وطلبوا من أبي الخروج معهم.
حسبته جاء ليطلب يدي
وسررت لأني كنت أحبه،
مع أنه ليس من قبيلتي،
ولا متعلّماً مثلي.
أردت البقاء،
لكن أمي أعطتني سلة ملابس
لأغسلها في النهر.
قالت “لا ترجعي
قبل أن تصبح نظيفة كروح السيدة العذراء”
قلت: “أماه، في هذه الحالة لن أرجع أبداً”
ثم سألتها: “هل أصطحب أخي معي”
بينما يهرع الأخير ويقف إلى جانب أبي.
كنت أضحك حين صرخت “اركضي”
وضحكت لأنها أخافتني.
وأنا أستدير حول الكوخ،
سمعت تات، تات، تات، من البنادق
كالتي يحملها الجنود.
عدوت أسرع والسلة ما تزال بين يدي
وظللت أحملها حتى وأنا اقفز في النهر.
ظننتني سأموت لذا أغمضت عيني.
حين ارتطم شيء ما فيّ
فتحتهما ورأيت جثة أبي.
وهو يطفو إلى جانبي
التفت ذراعه حول رقبتي،
وراحت تشدّني إلى أسفل
وأفلتّ السلة.
كان الرصاص يخترق مياه النهر
فبحثت عن جثة أبي واختبأت تحتها.
حماني جسده حتى انقطع عني النفس
وكأن علي الصعود إلى السطح.
حين زحفت على الضفة
اختبأت في أيكة خلف الكنيسة.
أخيراً حين تيقّنت من أن لا أحد في الجوار،
طرقت على الباب
حتى فتح لي الكاهن رجوته: “خبئني يا أبتاه”.
حين صرت في الداخل سررت لرؤية أمي.
قالت لي إنه حين أطلق جارنا الرصاص عليها،
تظاهرت أنها ماتت
وفيما يرمي أبي في النهر
هربت وجاءت إلى هنا
آملة أن أكون نجوت أيضاً.
قالت إننا نحتاج إلى مخبأ آخر،
لكنها لم تعثر سوى على فسحة ضيقة
وراء المذبح المغطى بطبقة حديدية.
الفسحة تتسع لإحدانا فقط لذا جعلتني أدخل
وغطّت الفتحة ثانية.
حين سمعت الصراخ أزحت الغطاء المعدني
ورأيت أمي تشتعل.
حاولت مساعدتها مستعملة يدي فقط،
لكن حين غطتها النار تماماً
كسرت الزجاج المبقّع
بتمثال القديس جوزيف وتسلقت النافذة إلى الخارج،
إلى النهر ثانية.
عبرت ريح فوقي
وفوق العشب والأشجار.
حين توقفت لأستريح،
التف الخوف حولي كأفعى،
لكن حين قلت لنفسي إنني لن أسمح لهم بقتلي
اتخذ شكل طائر وحلّق بعيداً.
زحفت ثانية إلى الكنيسة،
لأنني أردت العثور على رماد أمي
لأدفنه،
لكن الثوار كانوا يقطعون الطريق،
لذا انتظرت حلول الظلام.
ربما نمت. لا أعرف.
حين سمعت صوت جارنا
كأن الأمر كأنني صحوت من حلم.
غمرتني الراحة حتى جلست
ورأيته يقف فوقي حاملاً منجلاً.
قال: “لن أؤذيك يا أختاه”،
عرفت أنه يكذب وحاولت الهرب،
لكنني كنت واهنة جداً
وارتمى عليّ ممزقاً ثيابي.
حين انتهى
حسبته سيقتلني
لكنه قرّب المنجل من رأسي
وأسقطه من يده.
جاء الفجر على القرية وفي باله
المزيد من القتل.
سمعت الصراخ واستغاثات الرحمة،
ثم أدركت أن هذه الأصوات تأتي في داخلي.
وأنها لن تغادر أبداً.
الآن أحادث الموتى.
عظامهم تقرقع في رأسي.
أحياناً لا أستطيع سماع شيء آخر
وأذهب إلى النهر مع ابني وأبكي.
في الأيام الأولى لولادته
أخذته إلى هناك للمرة الأولى.
وقفت أتأمل المياه
التي كانت ما تزال مصبوغة بالدم،
ثم رفعته إلى الأعلى،
لكن عظام أمي كلّمتني: “القتل خطيئة”،
لذا أعدته إلى البيت
لأربيه كأنه ابني حقاً
وليس ثمرة جاري،
الذي عاد على هذا النحو لتعذيبي
بجلد يفوح باللحم المحترق،
لكن في صميم قلبي عرفت
أن أباه وأمه ماتا منذ زمن بعيد
وتركا هذا اليتيم ينمو
كزهرة مسمومة
حول القبر المفتوح
الذي كان بلدي.
كائنات مهددة بالانقراض
لون العنف أسود.
تلك هي الحقائق الواضحة
على خلفيّة بيضاء،
حيث حاصر رجال الشرطة العدو،
حيث لا ينبغي أن يكون، حيث هو مكشوف.
بالطبع لا يستطيعون دائماً أن يثقوا بعيونهم،
لذا عليهم الاتكال على حدسهم
الذي ينبئهم أنني غير قادر
على السلوك المتحضّر،
لذا أنا مذنب
بقيادة السيارة في حيّي
ويجب أن أتلقى جزائي
يجب أن أسترخي وأستمتع
كفتى طيّب.
أن لم يكن كذلك فهم مستعدّون لتطهيري
من أوهامي عن العدالة والحقيقة،
التي هي محيّرة حتماً،
مثل “الساسكواتش”
الذي بصماته وبرازه
هي الدليل الحسي الوحيد على وجوده،
مثلي، أنا البروفسور “اللامع” في الأدب،
وقد أخرجت بالقوة من سيارتي،
لأنني أبدو مثيراً للشبهة.
حقيبتي، المليئة بدروس اليوم،
يمكن أن تحتوي على المخدرات،
بدلاً من الأبحاث المصنّفة بحسب المضمون،
بدلاً من ألوان تلاميذي،
لكن من أنا لأقول
أن هذا لا يستحقّ الضرب أيضاً؟
أنه حلّ لا يتسبّب بارتباك
حول من يستطيع أن يفعل ما يريد بمن يريد،
لأن هناك خطّاً مباشراً
بين العبد والأثيم،
ووجهي المحدّق في الصحف والتلفزيونات،
أو الموصوف مراراً وتكراراً كذكر أسود.
إنني محروم من هويتي المستقلة
وينبغي دائماً أن أكون عِرقاً لا رجلاً
جاء للعمل في أرض الفرص،
لأن العبودية لم تختف حقّاً.
ببساطة ارتدت قناعاً جديداً
والآن تغذّي الخوف
المبرّر غالباً،
لأن انتحاريي الأقليات
قرروا أن يأخذوا أحداً معهم
ربما تكون أنت
تعبر النار،
مثلما أعلَّم
أن اللاعدالة هي طريقة أخرى
للنظر إلى الحقيقة.
في نقطة ما سنلتقي
عند رأس الرصاصة،
الشفرة، أو السوط
وهو يسحب الدم،
لكن أحدنا فحسب سيتغير،
أحدنا سيتسلل
متجاوزاً ربّأن هذه السفينة وملّاحيها
والخنوع الآخر إلى قيود أمة
قدمت الاستعارة
بدلاً من الوعود.
لانغستون هيوز
أغنية حبّ إلى أنطونيا
حتى لو غنيت لك
كل أغنياتي
ورفضت سماعها،
حتى لو بنيت من أجلك
جميع بيوت أحلامي
ورفضت العيش فيها،
حتى لو أعطيتك كل آمالي
فضحكت قائلة: لا تعنيني،
فسأعطيك حبي
وهو أكثر من أغنياتي
ومن بيوت أحلامي
أو أحلام بيوتي…
سأعطيك حبي
رغم أنك لم تمنحيني
ولو نظرة واحدة.
شباب عجوز
سمعت صوت طفل،
وكان صوتاً قوياً، واضحاً، مفعماً بالشباب،
لكن حين نظرت إلى وجهه
وجدته عجوزاً-
ليس بسبب السن،
بل بسبب المدينة،
بسبب العمل
بسبب الغبار
وسخام المعامل
آه، أيها الصوت الصغير
آه، أيها الوجه
الأشبه بربيع
بغير زهور!
الحصن
كنتِ آخر حصون أحلامي
وها قد هويت إلى التراب.
أنت أيضاً، لم تعودي أكثر من كذبة مهشّمة.
شيء ما
حال بيننا
شيء أخضر ودبق
مثل ضحكة دبقة،
كأس انكسرت
لم يعد يمكننا أن نشرب منها
وحين التفتنا
نثرنا الكسرات على الأرض
ومضينا كل في طريق
إلى المدينة
وكانت ساعة ما
في أعلى برج ما
تدقّ ببطء
ساعة بعد ساعة
صوتاً هائلاً مكسورااً.
كنتِ آخر حصون أحلامي
وها قد هويتِ…
غرفة
كلّ غرفة
ينبغي أن تكون مقفلة ومحمية
حين تكون بصحبة امرأة…
لكن ينبغي أن تكون مفتوحة
على وسع السماء
حين تكون وحيداً.
أغنية العبيد
بعيداً هناك أرى
النجمة التي لا تجلب الدعة
بعيداً في الشرق
أراها تلمع.
بعيداً في الغرب
أرى النجمة التي لا تبالي
لكنني أعرف
أنّ لي
نجمة تلمع في الشمال!
يا نجمة الدروب!
يا نجمة الامنيات!
يا نجمة الشمال!
كم أنت بعيدة؟
سلام
مررنا بقبورهم
وكانوا هناك
ولم يكن مهماً
من المهزوم منهم ومن المنتصر.
في ظلمتهم
لا يميّزون
من الذي يحمل
راية الانتصار.
أغنية صغيرة
البشر المستوحدون
في الليالي الموحشة
يجدون حلماً وحيداً
ويتشبّثون به.
البشر المستوحدون
في النهار الموحش
يعملون لكي يبدّدوا
مع العرق أحلامهم.
حزن
عينان
تجمّدتا
من عدم البكاء.
قلبٌ
لا يجدُ
طريقةً للموت.
أغنيات
جلستُ هناك
وغنيتُ لها في العتمة
قالت:
لا أفهم الكلمات.
قلتُ:
ليس من كلمات.
صحراء
يّ أحد
أفضل من لا أحد.
في الغسق الأجرد
حتى الأفعى التي تغزل الرعب
على الرمل
أفضل من لا أحد
في هذه الأرض الموحشة.
ليل هارلم
هارلم تعرف أغنية
بلا أنغام.
ثمة إيقاع
لكنّ اللحن عار.
هارلم تعرف ليلاً
بلا قمر.
ولا أحد يعرف
أين هي النجوم؟
روبرت بلاي
الحب عن بعد
توّاقون إلى الطين على ضفاف الأنهار
إلى الأرض السوداء حول الجزر.
حين تحدّث جيوفري رودل عن الحب عن بعد
كان يحمّم رأسه بدم الأسد.
لم يكن مولعاً إلى هذا الحد بالحرية! صرخ:
“أريد أن أكون أسيراً لدى العرب!”.
للحمامة النائحة أجمل الأسماء؛ نداؤها
العابر ينبعث من الأبدية على غصن رفيع من رماد؛
والأم تحاول الوصول إلى ابنها بصمت.
ما أن لمحت الحمامة الوجه،
حتى ضرب نبات “الخبيز” جذوره في الأرض.
وحدها المحارات المغروسة عميقاً تحمل اللؤلوء.
السباحون الذين يغطسون في البحيرة
يرون شعاع الشمس يقتل ثيران الماء.
انحنى يوسف ليتنفّس حين وضعه الغرباء في البئر:
“اصرخ حين تلمس رجلك القاع! سنتبع
الفقاعات إلى حيث مكانك”.
حتى تحت الجلد
يمكننا سماع نواح الحمامة.
مهد موسى
زوجات فرعون يمشين على الطين بأطراف الأصابع.
نطوف معاً، صديقان عزيزان، في مهد موسى،
لا يفصلنا سوى جلد رفيع عن مجهول النيل.
الأشباح تكوّن نفسها من الضباب الأرضي.
أرواحنا رطبة بطبيعتها. “الأرواح الجافة هي الأفضل”
كما قال أفلاطون، لكنه كان مربياًَ في الحادية عشرة.
بعض الأطفال يسمعون صوت الموتى الرفيع.
الرجال يفكّكون أسراراً مخبوءة في الأعداد الأولية.
النساء يخبرن ما أمرتهن الأبدية بقوله.
مهدنا، كمهد موسى، تنفذ إليه مياه النيل.
لم نحظ بيوم كامل من الضوء.
عند الثالثة سيتصدّع جدار، أو سيموت أرنب بري.
وصل الجمال إلينا مغمّساً بدم الولادة.
بينما عيناه مفتوحتان، دمه الناصع يملأ الأرض.
سقوط الطفل يمنحنا طعم الحرب.
بعض الأرواح يتذكّر جيداً، يتسلّق عالياً جداً
ويتذكر إلى الأبد. لكن ماكبث سقط على بعد ألف ميل
حين لمست ريشةٌ وجهه.
كالديرون
كل خلد وابن عرس ما هو إلا ظل تقذفه الشمس.
كل فأر وقنفذ ما هو إلا ظل.
لذلك تستطيع جميعها الاختباء في أوراق الشجر.
لا تعزّني بوضع الزهور في غرفتي.
لا تقتبس لي قصائد كالديرون السرية.
لا تلفظ كلمة حرية في غرفة الإعدام.
كل يوم أصحو، سيد الحواس الجشعة يستشعر
طريقة جديدة لكي ألقي رأسي على سطح المكتب.
وفي حفلات الزفاف أحسد حتى القس.
في كلّ نفس أتنفسه يريد أن يخرج أولاً
ولا أمانع. كثير من الظلم
يخرج إلى العالم عبري.
نتغذى بهجران الظلال.
ما يفيض هو ما يبعدنا عن الله.
أما الأديرة التي تحترق فتبنى في عالمنا.
رقائق الثلج ترسم أشكالاً كثيرة.
الكثير من أذيال السلمون تتلامس في العتمة.
الكثير من سمك الهلبوت يقع في شباك اليأس.
التشابه بين حياتك والكلب
لم أقصد قطّ أن أعيش هذه الحياة،
صدّقني لقد حدثت هكذا فحسب
كما يظهر كلب فجأة في مزرعة،
ويروح يهزّ ذيله دون أن يجيد الشرح.
من الجيد أن تتمكّن من قبول حياتك:
ستلاحظ أن التجاعيد غزت وجهك
في محاولة التأقلم معها.
كان وجهك يظنّ أن حياتك ستبدو
كمرآة حمامك حين كنت في العاشرة.
حين كان هنالك نهر صاف لامسته رياح جبلية.
حتى ذووك لا يصدقون كم تغيّرت.
عصافير الدوري في الشتاء، إذا حدث وأمسكت أحدها،
تفر من يديك في زقزقة من نار. وتراها لاحقاً على الأشجار.
يمتدحك المعلّمون. لكنك لا تستطيع العودة إلى دوري الشتاء.
حياتك كلب جعله جوعه يقطع الأميال إليك.
لا يحبك بالضرورة،لكنه يستسلم، ويدخل.
شهر من السعادة
حصان أعمى يقف بين أشجار الكرز.
والعظام تلتمع من الأرض الباردة.
يثب القلب إلى السماء تقريباُ!
لكن المراثي تعاود شدّنا إلى الظلمة.
يأخذنا الليل. لكنّ مخلباً
يبرز من الظلمة لينير الطريق.
سأكون على ما يرام.
سأتبع آثاري المضيئة في الليل.
خريف خاص
ذرات الغبار ترتفع وتهبط
بخطوات جليلة بطيئة،
مثل خدم يرقصون في الفناء
احتفالاً بمولد أمير ما.
ما الذي ولد؟ إنه الشتاء.
إذاً كان المصريون القدماء محقّين.
كل شيء يتحيّن فرصة لكي يموت،
لكي يولد في هواء الخريف النقي.
كل وريقة شجر تقع وتغوص
حينما لا نتوقع ذلك البتة.
ننظر إلى النافذة
بحثاً عن شيء جذب أبصارنا.
قد يكون الخريف قبر
يولد منه طفل.
نشعر بفرح سرّي
ولا نخبر أحداً!
لمَ لا نموت؟
في نهاية سبتمبر ثمة أصوات كثيرة
تقول لك إنك ستموت.
تلك الوريقة تقول لك. ذلك البرود.
جميعهم محقّون.
أرواحنا الكثيرة – ماذا يمكنهم
أن يفعلوا بها؟
لا شيء. فهي جزء
من اللامرئي.
أرواحنا كانت تتوق
للعودة إلى ديارها على أي حال
“تأخر الوقت”، تقول،
“أقفلوا الباب، فلنرحل”.
لا يوافق الجسد. يقول:
“لقد دفنا كرة معدنية صغيرة
تحت الشجرة.
فلنذهب ونأتِ بها”.
رسالة في أكتوبر
بات الفجر يتأخر أكثر فأكثر،
وأنا، الذي منذ شهر فقط
كنت أجلس مع القهوة كل صباح
مشاهداً الضوء يهبط سفح الهضبة
إلى حافة البركة
ويضع أرنباً هناك، ليشرب بوجل،
ثم الضوء يعبر الماء
راسماً الانعكاسات
على الجانبين،
أشجار نمت كأنما بسحر ساحر،
لا أرى الآن إلا وجهي
تعكسه الظلمة، شاحباً وغريباً،
وقد أجفله الزمن. بينما أنام،
الليل بسترته الشتوية السميكة
يمسك الأرنب بلمسة من
أوراق الشجر المبللة ويقود طريقه،
ثم يجلب حصانه الأسود
الذي يرتعش كجداجد الليل،
وحول المياه خضراء في الأسفل.
أصحو
وعند النافذة المنتظرة
أجد الستائر مفتوحة أمام وجهي المفتوح؛
حولي، الظلمة.
وأنا، الذي لم أكن أتمنى
سوى الاستمرار في النظر إلى الخارج
عليّ الآن
الاستمرار في النظر إلى الداخل.
قلب من ذهب
إنها زجاجة جعة قديمة
بقلب من ذهب.
هناك الكثير من الانكسار على هذه الأكتاف
المليئة بقشرة الرأس،
التي أبلتها سنوات التسكع مع الصحبة الطيبة
في الريح.
ليست هذه زجاجة للرمي.
إنها مليئة بالأسف والقصص المحزنة،
ها هي تعود إلى حياتك مرة بعد مرة،
جاهزة للوقوف أمام كل من تعرفهم
وتدعك تقشّر ورقتها.
الآن من سطح الطاولة الفورمايكا
ترفع إلى فمك
فمها العذب الأليف.
امرأة عمياء
رفعت رأسها إلى شلال من الضوء
وجاءت تبتسم.
الضوء انحدر في خط رفيع
من جبهتها إلى عينيها،
ثم إلى عنق قميصها
وبلل أعلى ثدييها الأبيضين.
حذاؤها البني
طرطش في الضوء.
كان الأمر
كأنما سيرك يمرّ بقربها
على برك من الضوء،
قفص على عجلات،
مشت مسرعة خلفه،
متحمسة، فضولية، تدفع عكازها
عبر القضبان، تلكز وتلكز
بينما العالم الجبان
تقهقر في الزاوية.
الأحذية
في مستودع الأحذية،
البيوض البنية الناعمة للأحذية الجديدة،
تلمع في العلب،
تعشّش في رداء العمادة،
تحدّق بأجفانها
لكن ألسنتها ما زالت مطوية
في قبضات صغيرة سوداء.
دعونا لا نخبرها الآن
أنها جميعاً
ستصبح مثلنا جميعاً،
ستقف في الطوابير
بحسب اللون والجنس والحجم،
في متجر الأحذية المستعملة…
ستصبح أحذية قديمة مجعدة،
تضع أيديها الجافة على ركبها،
التي انثنت أصابعها إلى الأعلى
من تسلّق الهضبة إلى الأبد
تحت المطر.
رزمة من ورق اللعب البورنوغرافي
كنا في العاشرة أو الحادية عشرة، صديقي وأنا،
حين وجدناها تحت الجسر
حيث خبّأها أحدهم بعناية
فوق عارضة خشبية اتخذها الحمام عشاً.
في كل منها صورة بالأبيض والأسود
ولا واحدة منها تشبه الأخرى.
غرقنا في الصمت
وشعرنا أننا بتنا أكبر،
بتنا شابين نجلس على أعقابنا محدّقين
بما يمكن أن يكون عليه المستقبل.
عاد الحمام هادلاً مخربشاً.
وبقبق النهر منسلاً من ظلّ الجسر البارد.
كان ثمة نسوة مع كلاب ضخمة،
نساء مع زجاجات،
نساء مع عصي مكانس.
ونساء تعلوهن الجياد.
والنسوة كن يبتسمن ويلعقن شفاههن
بألسنة كالأشواك.
كبرنا.
بتنا عجوزين متصلبي الأقدام
واهني القلوب.
أردنا أن نضحك لكننا لم نستطع.
كنا نحسب أنفسنا مجرد صبيين
جاءا لكي يرميا بعض الحجارة على الحمام،
لكننا كنا قد بدأنا
نموت من الداخل.
ممر المشاة
يمتد بين مبنيين فوق الشارع المزدحم
مثل شرنقة عملاقة
بين عدم وعدم،
وفي داخله فتية مراهقون بسترات جلدية
يستندون إلى الجدران، محركين أفواههم،
متنفسين بخاراً في الهواء،
وجوههم مشدودة وجافة،
كل واحد منهم
ينتظر أن تنكسر قشرته السوداء القاسية
وأن ينفتح جناحاه الرائعان.
في أثناء مرورك
من وسط الحيّ أراك قادماً،
تمشي رشيقاً، تحمل أكياساً،
وتحدّق بنهم في وجوه المارة
باحثاً عن شخص تعرفه،
ممسكاً ابتسامتك كفقاعة في فمك،
محتفظاً بها رطبة جاهزة،
محاذراً ألا تبتلعها.
أعرف الأمل على وجهك،
أعرف كيف أن قلبك يرتفع فقط ليرى
واحداً منا يتذكر.
فقط لو ينادي أحدهم اسمك، لو يبتسم،
سعيداً برؤيتك مجدداً.
تنقل الأكياس إلى اليد الأخرى،
ترفع كتفيك،
وتمضي قدماً إلى مثل هذه اللحظة.
على بعد بضعة أقدام تعرفني،
أو تحسب أنك تعرفني.
أراك تحضّر وجهك والتحية.
هل أعرفك؟ كلانا يتساءل. بسرعة نلتقي ونمر،
محولين أبصارنا بما يكفي للمس،
لكننا لا نتلامس.
لم أستطع أن أدعك تعرف
أنني نسيت،
رغم أنك تعرف.
أمسية شعرية
ذات يوم كنت شاباً على ضفة نهر،
مرصوصة بالأشجار
وكان لك جناحان ناعمان وكتفان أحمران.
غنيت لنفسك
لكن الجميع أصغى إليك.
الآن أنت طائر مالك الحزين عجوز أصفر العينين
برقبة عصبية وصلبة كالأفعى.
تفتح كتابك على العامود الفقري
لسمكة
تختار الأضلاع الصعبة،
مغمضاً عينك السليمة
بينما تلتهم كلماتك.
قصة شبح
كانت حياتها بسيطة، وكان موتها عادياً،
فتاة خيطت إلى كفن ذات الرئة.
كانت مجرد مريم أخرى، هناك في إلينوي،
وكان مجرد أبريل آخر،
براعم “صريمة الجدي” انحنت في الصلاة
عينان منسيتان،
ابتسامة منسية،
غرة شعر منسية،
كل شيء راح.
لكن منذ سبعين عاماً
يضوع قبرها
برائحة الورود.
ضفة النهر
في أشجار الحور
صخب
الجيوش.
في أشجار الصفصاف
همس
المحظيات.
كل شيء على حاله
كل يوم
في هذه المملكة،
والضفدع يخرج
إلى السوق،
رامشاً.
شرر
خربشت اسمك على الهواء الليلي،
ثم خربشت اسمي.
لم أستطع رؤيتك بجانبي،
تضحكين وتطاردين اسمي
في الهواء،
لكن أظن أنني سمعت قلبك
وأحسست أنفاسك في العتمة.
كلمة واحدة خرجت من يدك
هرعت لكتابتها حتى النهاية
قبل أن تنطفئ حروفها الأولى.
خلّفت خطاً أحمر
يرتعش في العتمة
وكان هذا اسمي،
كان هذا اسمي.
الكنّاس
إنه الصباح.
أبي يكنس الرصيف أمام متجره،
يقف مستقيماً في مقدّم القارب،
مبدّداً شوارع حياته الرمادية
التي لا تنتهي
بمجذاف أصفر قديم،
سعيداً هناك،
يلوّح لأصدقائه.