أميركا اللاتينية في مرآة أدبها
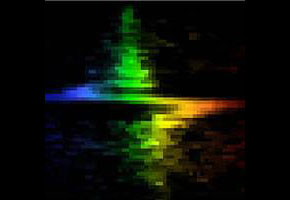
فرنان بروديل
تتكون القارة الأميركية من مجموعتين ثقافيتين كبيرتين: أميركا من دون وصف أو تعريف، للإشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي ينبغي أن نضيف إليها كندا السائرة في ركابها والمقتفية أثرها. ذلك هو العالم الجديد بامتياز، عالم الإنجازات الرائعة و”حياة المستقبل”. أما أميركا الأخرى، الأكبر مساحة، فيبدو أنها تقبلت صفة “اللاتينية” الحديثة التي أطلقتها عليها فرنسا (حوالى عام 1865، وليس من دون مقاصد مبيتة) ثم تبنتها أوروبا من بعدها. أميركا هذه واحدة ومتعددة؛ مزركشة كثيرة الألوان؛ مأسوية، ممزقة ومنقسمة على نفسها.
إن البدء بأميركا “اللاتينية” هذه يتيح تجنب المقارنة المباشرة، التي يمكن أن تسحقها مسبقاً تحت الثقل الواضح لتقدم أميركا الشمالية الهائل. إنه يمكِّننا من رؤيتها على نحو أفضل، بذاتها وبالصورة التي تستحق أن يُنظر إليها: بأنسيَّتها العميقة ومشكلاتها الخاصة وتقدمها في خطوات واضحة. لقد كانت في الأمس متقدمة كثيراً على أميركا الأخرى، وكانت أميركا الأولى في الثراء الذي جعلها محط الأطماع. كان ذلك في الأمس. ثم دار دولاب الحظ. إن مصير أميركا اللاتينية الراهن لا يتصف أبداً بالكثير من الهناء أو السعادة: إنه مصير ملبَّد بالظلال. وفجرها لم يبزغ حقاً بعد.
الجغرافيا والطبيعة والمجتمع: شهادة الأدب
تتغير أميركا اللاتينية، سريعاً وبلا انقطاع، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. لذا، يمكن صور الأمس أن تفقد قيمتها غداً، أو تبدو زائفة.
ومن لم يستطع أن يراها بعينيه، فعليه على الأقل أن يقرأ أدبها الرائع – المباشر، الخالي من التعقيد، الملتزم التزاماً صادقاً بسيطاً وصريحاً. إنه أدب يتيح الفرصة للقيام، عبر الفكر، بألف رحلة ورحلة؛ وشهادته على الواقع تتخطى في وضوحها كل ما يمكن أن نجده في التحقيقات الصحافية والدراسات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية (على رغم أن هذه الأخيرة ممتازة في غالبية الأحيان).
يكشف لنا الأدب أيضاً – وهو أمر لا يقدَّر بثمن – العطر والكنه لبلدان ومجتمعات لا تزال قابعة في عزلتها وتتسم غالباً بالسرية، على الرغم مما في ترحيب أهلها من دفء وانفتاح.
* على المستوى الجغرافي، تشكل أميركا اللاتينية فضاءً شاسعاً. وتبدو كتلتها البشرية مبعثرة وكأنها تعوم في رداء فضفاض هائل الأتساع. فهناك فيض من الأرض، فيض من المساحات يبعث الدوار أو السكر.
بالطبع، بعدما قلل الطيران من هذا الاتساع المهول وجعله أكثر إنسانية، إذ اختصر المسافات ومحاها، صار أكثر فأكثر احتمالاً أن تغيب عن بال المسافر الأجنبي هذه السمة الأساسية لأميركا اللاتينية.
فحتى في الأمس القريب، صار اجتياز حوض الأمازون أو الطيران فوقه لا يستغرق أكثر من ست ساعات، لأن السفر عبره لا يزال وعراً للغاية: “إنه بمثابة الغابة” isto e matto كما يقول البرازيليون. وكانت الرحلات عبر جبال الأند، ما بين الأرجنتين وتشيلي، تقوم بها، في ذلك الوقت، طائرات خفيفة ذات محرك مزدوج، فتطير في قلب وادي الكومبرا، فوق قطار السكك الحديد الصغير مباشرة، فإذا بالرياح تؤرجحها تارة نحو هذا الجانب وطوراً نحو الجانب الآخر للوادي الواسع، لكن دائماً ما بين الجبال، وتحت سفوحها وقممها المرتفعة. أما اليوم فتقوم الطائرات ذات المحركات الأربعة بالطيران كل يوم تقريباً فوق هذه الحواجز. لم يعد إجتياز جبال الأند يستغرق أكثر من 15 دقيقة: 10 دقائق منها فوق السفوح والقمم الجليدية التي تتلامع تحت أشعة الشمس، ومن ثم تنحدر الطائرة نحو سهول الأرجنتين المقفرة أو الساحل التشيلياني. فوق هذا كلّه، تعمم الطيران على نطاق واسع وصارت أغنيته الرتيبة تتردد في أرجاء أميركا اللاتينية كلها.
لكن، في الواقع، وحدهم قلة من المسافرين المحظيين يستمتعون بهذه القفزات المدهشة، والرحلات الباذخة التي تنتزعكم من مكسيكو، حيث تكون رياح الشمال (Nortes) قد جلَّدت نباتات الحدائق الخضراء، لترميكم بعد لحظات في قيظ يوكاتان أو فيرا كروز، أو تضعكم على مقربة من المياه الفردوسية وزهور ساحل المحيط الهادئ في أكابولكو. وبالمثل، وحدها السلع الثمينة أو ذات المردودية العالية يجرى نقلها جواً: ثمار البحر التي تحملها الطائرات من تشيلي إلى بوينس أيرس، الدواب واللحوم الممتازة التي تنقلها الطائرات من مندوزا إلى سانتياغو أو إلى مناجم الشمال التشيلياني الصحراوي.
إذاً، لا يزال تقلُّص المسافات أمراً استثنائياً، على الرغم من المظاهر البادية. في مطارات ريو دا جانيرو، تهبط طائرة أو تقلع كل دقيقة. لكن الركاب ليسوا أكثر من جزء ضئيل من السكان، أي البورجوازية، يمكن القول. فالطائرة في أميركا اللاتينية لا تلعب دوراً مماثلاً لدور وسائل النقل الشعبية (القطارات والحافلات والسيارات الخاصة) التي وفرت لأوروبا شبكات مواصلات كثيفة ومحكمة.
لا تزال أميركا اللاتينية تعيش في ذلك الفضاء نفسه الذي عاشت ونشأت فيه: فضاء تُقاس فيه المسافات بخطوات البشر والدواب. فلا نقيسنَّ مسافاتها بسرعة السكك الحديد، فهي نادرة؛ ولا بالطرق، وهي أحياناً رائعة، مثل كرتيرا المكسيك، لكنها قليلة وفي طور الإنشاء أو الإصلاح الدائم. لا تزال أميركا اللاتينية موسومة بهذا البطء. وعلى المرء أن يدرك خضوع كل شيء فيها لهذا المدى الهائل للمسافات لكي يستطيع أن يرافق، بمخيلته، على ظهر حصان، أو مشياً على الأقدام بخطوات ثقيلة مجهدة، شخصية مارتن فييرو، راعي البقر في العصر البطولي، التي ابتدعها خوسيه فرنانديز في عام 1872، أو سيغوندو سومبرا آخر رعاة البقر الجوالين الأحرار في سهول الأرجنتين، الذي اختلقه بدوره المبدع ريكاردو جيرلاديس في 1939. إن مثل هذا الإدراك ضروري ليتمكن المرء من مشاهدة أدغال شمال شرق البرازيل في مناطق القحط والجوع التي وصفها يوكليدس دا كونها في Os Sertoes (1902)، وعليه أيضاً قراءة النصوص الرائعة عن المساحات الشاسعة في مناطق الأرجنتين الداخلية التي لا يزال يسكنها الهنود – تلك النصوص التي كتبها يوماً بيوم لوسيو مانسيلاّ لصحيفة لاتريبونا La Tribuna في بوينس أيريس عام 1870 في عنوان “رحلة في بلاد الهنود” (a los Indios Ramqueles una eæcursion)، وهناك كذلك نصوص الروائي الواقعي وليم هنري هدسون (1841 – 1922)، الإنكليزي الحامل الجنسية الأرجنتينية، عن باتاغونيا التي كانت لا تزال عندئذ منطقة عذراء فارغة فراغاً مطلقاً.
ويجب أن لا ننسى كتابات الرحلات الرائعة للألماني ألكسندر فون هومبولدت (1769 – 1859) والفرنسي أوغست دو سان هيلير (1799 – 1835)، اللذين كانا على رغم أنهما أجنبيان، مفتونين بالبلاد التي وصفاها، الى درجة أن كتابتهما اعتبرت منذ البداية جزءاً من أدب أميركا الجنوبية. ولا شك في أن من أكثر صور تلك الرحلات الكلاسيكية قوة وحيوية، صورة قوافل البغال بطرقها المحددة الثابتة، ومواقيتها المنتظمة تقريباً، “ومحطات” توقفها الـ conchos حيث كان الناس والحيوانات والبضائع يمضون الليل قبل استكمال رحلاتهم في اليوم التالي. وقد وُصفت قوافل البغال هذه بأنها أولى خدمات الشحن، بل أولى السكك الحديد! فقد كانت يقيناً أولى وسائل السيطرة على تلك المساحات الوحشية التي، حتى اليوم، لا تزال شاسعة وموحشة. وإذا كان الناس هناك لم يتجذروا ويستوطنوا على نحو صريح مثلما في الغرب، فظلّوا إلى اليوم يتخلون بسهولة عن موطنهم وأرضهم، فذلك لوجود فيض من الأراضي والمساحات. وفي أيامنا هذه، لا تزال قوافل القطعان تجري كالأنهار في قلب القارة الأميركية، مثلما كان يحدث في القرنين السادس عشر والسابع عشر، إلى أن تصل في نهاية المطاف إلى الأسواق التقليدية للماشية، مثل تلك الموجودة في دول باهيا في البرازيل. إنها طريقة بدائية وقليلة الكلفة في استغلال الموارد، كنوع من رأسمالية غير مكلفة طالما أن الأرض متوافرة مجاناً أو بشكل شبه مجاني.
إذاً لا غرابة البتة في نهاية المطاف أن يحكم الناس، الضائعون التائهون في هذه المساحات الشاسعة، والمدن (خاصة المدن) الواقعة على بعد شهور وشهور من العواصم الأوروبية ومن عواصم المستعمرات، والأقاليم التي تفوق مساحة بعضها مساحة إيطاليا أو فرنسا – لا غرابة في أن يحكموا أنفسهم كما يحلو لهم، وخصوصاً في الأمس، إذ ليس هناك من بديل، ويجب أولاً كسب معركة العيش والبقاء. إن “الديموقراطية الأميركية” في الأميركيتين، بما فيها “الحكم الذاتي”، هي جزئياً وليدة هذا الفضاء الشاسع؛ هذا الفضاء الذي، طالما لم يجر الانتصار عليه، ويستهلك كل شيء، ويحافظ على كل شيء في الوقت نفسه.
* حتى الأمس القريب، كان لا يزال الحلم الكبير (الهدف الرئيسي) تخليص الفلاحين من براثن الطبيعة البربرية. ففي أميركا الجنوبية، خلقت الطبيعة، ولا تزال تخلق شخصيات أو أنماطاً بشرية مدهشة، فقراء وخشنين وكادحين، على مثال “الغوشو”، الراعي الأرجنتيني الجوال في سهل البامبا العشبي الشاسع، و”الكابوكلو” البرازيلي الذي يعيش من الصيد والزراعة المتجولة، و”البيون” الفلاح المكسيكي الذي ينتفض ويثور ما أن يتوفر له زعيم حقيقي، كما هي الحال مع إميليانو زاباتا (E. zapata) المدهش، الذي استمر يقاتل حول مكسيكو من 1911 إلى 1919 .
ألم تكن المشكلة الحقيقية، عندئذ، تخليص هؤلاء من البؤس الذي كان يشكل حقاً الجزء الأساسي من “بربريتهم”؟ لقد حلم بذلك كل المثقفين المتحمسين في القرن التاسع عشر، وأيضاً في القرن العشرين. ولا يحتاج الأمر الى ترويض هؤلاء (إلا في حال الضرورة) مثلما تروّض الأحصنة البرية، بل الى تعليمهم القراءة وسبل العيش الأفضل والعناية بصحتهم. إنها مهمة ملحة ولا تزال تستلزم الكثير قبل أن تنتهي. هكذا، لا تزال حملات محو الأمية سائرة وتقوم بها بحماسة وجنباً إلى جنب مجموعات متجولة من المعلمين والأطباء والمرشدين الصحيين.
لقد احتل الفلاحون، هؤلاء الأبطال البرابرة، حيزاً مهماً في روايات القرن التاسع عشر والقرن العشرين. وكانت روايات الأمس هذه تبرز صراعهم مع الحضارة على صورة مبارزة غرامية حقيقية. وجعلت هذه الرمزية العاطفية من تلك الروايات روايات ميلودرامية أو “زهرية”، كما يقول الفرنسيون، لكنها تبقى مع ذلك شهادات ذات قيمة دلالية، بل يكفي دفعها أو تحويرها قليلاً لتتحول روايات سوداء.
فمالاتن فييرّو (1872)، مخلوق بدائي يعيش في سهل البامبا الأرجنتيني، لكنه شاعر ينشد ويغنّي قصائده، وها هي رقة الحب تنتزعه من حياته القاسية، فتتكامل مع رقة الشعر. لكنها تنضاف أيضاً إلى “نقطة الشرف” (Pundonor) التي تدفع غالباً إلى استلال السكين وتوجيه الطعنات في الـ Puleria، تلك الكباريهات (الحانات) المحصنة التي تبيع الخمور في وسط السهوب الخالية. أما رواية دونا باربراDona Barbara فقد اختار لها رومولو خاليخوس امرأة لتكون شخصيتها المحورية (وقد أصبح الراوي في ما بعد رئيساً تقدمياً لفنزويلا عام 1947 لكنه ما لبث أن تعرض لانقلاب عسكري أطاحه في 1948). وجرى اختيار اسم بطلة الرواية لكي يبرز الاسم بوضوح دلالات شخصيتها: فهي جميلة وفاتنة، لكنها أيضاً همجية سافلة وعديمة الضمير، ولديها من السجايا والعيوب ما يمكنها من الحصول على ما تريد من دون خجل. لكن، لا خوف البتة، فهي مع ذلك لا تستطيع في النهاية أن تهزم “دكتور القانون” الدمث والساذج والمحبب الذي أعادته مصادفات الميراث إلى قلب الحياة الرعوية، إلى تلك السهول الواقعة حول منابع الأنهار التي تصعد عبرها القوارب في بطء شديد يبعث على اليأس، إلا أنه بطء يمنح المسافرين على الأقل فرصة التصويب على التماسيح النائمة.
أما بطلة رواية Negra Angustias (التي جعلت مؤلفها فرنسيسكو روخاس غونزاليس يفوز بجائزة الأدب القومي المكسيكي في 1944)، فهي أيضاً جميلة ساذجة، لكنها كذلك – وهذا ما يجب أن نصدقه وإلا انهار البنيان الروائي – زعيمة عصابة فظيعة لا ترحم. لكن، ذات يوم طيب، يتم ترويض هذه النمرة البريئة فجأة على يدي معلم متواضع يعلمها القراءة. هكذا، تحدث المعجزة، وتتزوج انخستياس من معلمها وتستسلم للحضارة.
ليست كل الروايات المكتوبة على هذا النمط، عاطفية متفائلة. فرواية La Voragine التي كتبها الكولومبي خوسيه إستاسيو ريفيرا، عام 1925، هي قصة حزينة لزوجين تبتلعهما أدغال الأمازون. لكن سواء أكانت ميلودرامية “زهرية” أم سوداء، فإنها تلقي اللوم دائماً على الطبيعة التي توحِّش البشر ولا بد من السيطرة عليها للتمكن، في الوقت نفسه، من تحضير الإنسان أو تحريره. ووفق ما يراه الروائي التشيلياني بنجامين سوبركازو فإن سوء حظ تشيلي يتمثل في “جغرافيتها المجنونة” (1940, Chile o una loca geografia).
هذه الرؤية وهذا الأدب ينتميان إلى الأمس. وهما يختفيان اليوم تدريجياً وراء الأفق، وهذا ما يدعو أحياناً إلى الأسف.
* لقد أخذ في البروز أدب نضال اجتماعي وفلاحي. فاليوم، لا يزال البائس الفقير المعزول عن العالم بسبب الطبيعة أو المسافات أو بؤسه بالذات، هو البطل الأدبي بامتياز؛ لكنه صار يجري تناوله كنوع جديد من الأدب المقاتل العنيف والمباشر والغني بألوانه. فيقدم ذاك البطل بوصفه ضحية المجتمع قبل كل شيء آخر، بل ضحية الحضارة التي تبدو في الحقيقة غير مبالية إزاء حياته ومعاناته الرهيبة، قدر لا مبالاة الطبيعة المتوحشة نفسها.
يمثل هذا الأدب نقطة تحول، بداية حقبة جديدة. نغمته ثورية بالتأكيد. إنها تشهد على وعي حاد بمشكلات أميركا الجنوبية الخاصة، وعلى تلاشي الثقة في المنافع المنتظرة من “الحضارة” في ذاتها. ومن هنا تأتي واقعيته الكئيبة ويأسه.
هكذا، تبدو رواية Los de abajo (أناس الأسفل، 1916) للروائي المكسيكي ماريانو أزويلا (1873 – 1952) كناية عن صرخة تحدّ طويلة فحسب. إنها تلقي بنا في تلك الثورة الجماهيرية المعقدة التي انطلقت ابتداء من عام 1910 على الأقل، والتي صنعت على نحو غير مكتمل المكسيك الحديثة، وكان ثمنها زهق أرواح قرابة مليون من المواطنين المنكوبين بالفقر. وهي تروي قصة حفنة من الجنود الثوريين الذين كان مصيرهم الموت (والذين شاهد المؤلف موتهم لأنه كان هو شخصياً طبيب مجموعة من الثوار)؛ إنها قصة خيبة أمل فقراء متمردين في صراع ميؤوس منه مع مجتمع لا يعرف الشفقة، أثرياؤه فاحشو الثراء والشراسة؛ وفقراؤه شديدو الفقر، فائضو العدد والسذاجة.
وتجمع الروايات الطويلة جداً للكاتب البرازيلي الكبير جورج أمادو، والتي تدور حوادثها جميعاً في باهيا، في الشمال الشرقي البرازيلي، موطن الجوع والهجرة والفقر الأبدي، بين عنف وجمال لا نظير لهما. ومهما تكن طبيعتها الملتزمة، ونبرتها التي تقترب من المرافعة، فإنها تشكل شهادة استثنائية وحقيقية على حال الفلاحين الذين لا يزالون في بدائية لا تصدق؛ شهادة على مآسي الجوع في ريف إقطاعي تقريباً، حيث لا يجد الناس فيه حتى عذوبة الطبيعة لكي تقدم لهم العزاء.
في أرجاء هذا الأدب كلها، تطالعنا الشهادة المؤلمة نفسها. ها نحن مع الروائي جورج إيكازا في بلاده الإكوادور التي تبدو صغيرة على الخريطة، لكنها في الواقع أكبر من إيطاليا وتبلغ مساحتها 450 ألف كم2، وكانت قبل سنوات (في نهاية الخمسينات) أعلنت استعدادها لاستقبال مليون مهاجر، وهي بالفعل قادرة على استيعاب هذا العدد بسهولة إذ لا يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة. في الإكوادور إذاً، يأخذ ألفونسو بيريرا بطل رواية جورج إيكازا، Huasipungo (1934، وصدرت ترجمتها الفرنسية عام 1946)، أسرته عائداً إلى مزرعتهم الواقعة في أعالي الجبال، النائية والبعيدة عن كويتو ولا تصل إليها إلا طريق وعرة تسلكها البغال فحسب. لم يكن في وسع بيريرا البقاء في المدينة، فقد حملت ابنته من هندي دفعتها حماقتها للوثوق به، وفي الجبال فقط يمكن أن تمر هذه الولادة غير الشرعية من دون أن يلحظها أحد. إنها لرحلة جبلية غريبة. عندما بلغت البغال مشارف مستنقعات الأعالي، غاصت في الوحل. ترجل الجميع؛ “وبعدما مسح الهنود الثلاثة بأكمامهم وجوههم التي كساها ضباب متجلد، استعدّوا لحمل مستخدميهم على ظهورهم: خلعوا عباءاتهم البونشو، وشمروا سراويلهم الخشنة الفضفاضة حتى أفخاذهم، ونزعوا قبعاتهم الصوفية، ولفّوا عباءاتهم حول أعناقهم مثل أوشحة قطّاع الطرق، معرضين أجسادهم للسع البرد القارس الذي يتخلل الفتحات والثقوب التي تملأ ملابسهم القطنية … ثم قدموا أكتافهم بحيث تستطيع الأسرة (الأب والأم والابنة) الانتقال من ظهور البغال إلى ظهور الرجال”. ومضت القافلة وهي تغوص في الوحل الجليدي.
إنه أدب مفتعل قليلاً، لكنه مثير للمشاعر دائماً. وربما بسبب قسوة الواقع الاجتماعي، استغرق هذا الأدب في ما يمثل تمثيلاً أساسياً مسألة ريفيّة فلاحية عنيفة، ورضي بأن يقتصر على رؤية بؤس الريف وحده. أما بؤس العمال في المناطق الصناعية، أو مناطق المناجم البعيدة فقد بقي خارج رؤية هذا الأدب وتجربته. ومن الشهادات النادرة والمؤثرة التي نشرت عن البؤس المديني (باستثناء الدراسات العلمجتماعية (السوسيولوجية) التي تبقي مقتصرة على مجموعات صغيرة من المتخصصين) شهادة مفاجئة لزنجية برازيلية، أميّة تقريباً، اسمها كارلينا ماريا دي خيسوس، وهي كانت تعيش في إحدى مدن الصفيح في ساو باولو، حيث كانت تكتب يومياتها. ليس هذا التسجيل اليومي عملاً أدبياً، ولا بالطبع دراسة سوسيولوجية، لكنه وثيقة صافية في صورتها الخام. (نشرت “ستوك” الترجمة فرنسية عام 1962 تحت عنوانLe Depotoir).
باستثناء بعض الكتابات النادرة، مثل هذه اليوميات، وقع الأدب في مجمله أسير البؤس الريفي؛ بؤس يبدو محروماً من أي أمل، ولا يعثر على علاج آخر سوى التمرد والعنف والثورة. وهذا، بلا شك، أحد الأسباب التي جعلت لثورة فيديل كاسترو في كوبا، التي تمثل ثورة فلاحية إلى حد كبير، مثل هذا التأثير في أرجاء أميركا اللاتينية كلها. ومهما يكن مستقبلها أو مصيرها، فهي تشير إلى لحظة تاريخية. إنها تشير على الأقل إلى الحاجة المطلقة لدراسة جديّة لمشكلات أميركا اللاتينية السياسية والاجتماعية، وللحلول التي تتطلبها. وهذا شيء يعيه مثقفو أميركا اللاتينية جميعهم، مهما تكن آراؤهم الشخصية ¶
* من كتاب يصدر قريباً بالعربية.
“مباني الحضارات”، واحد من كتب المؤرخ الفرنسي الكبير الراحل فرنان بروديل كتبه في مطالع الستينات من القرن الماضي، ليكون مرجعاً مساعداً لطلبة الصف الأخير من المرحلة التعليمية الثانوية في فرنسا. يعرض الكتاب للمعطيات التاريخية والاجتماعية والثقافية للحضارات الأساسية على اختلافها في عالم اليوم. من هذا الكتاب، اخترنا مطلع قسمه الثاني حول حضارة اميركا اللاتينية من خلال أدبها.
(ترجمة مروان أبي سمرا)




