سينما نظيفة
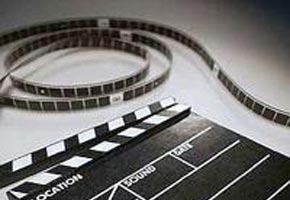
نديم جرجورة
لعلّ أسوأ ما واجهته السينما المصرية في تاريخها القريب، كامنٌ في إسقاط تعبير مصطنع عليها شوّه المعنى السامي للفن السابع: «السينما النظيفة». ففي ظلّ تنامي الأصوليات المتفرّقة في المجتمع المصري، والتدهور الخطر الذي أصاب بُنَاه الاجتماعية والثقافية والنقابية والإعلامية؛ استعادت أفكار متزمّتة حضورها، وراحت تمدّ شبكتها العنكبوتية في مفاصل هذا المجتمع. لم تنجُ السينما من هذا المرض الخبيث، الذي ضربها في الصميم بأشكال جمّة، ومنها مقولة «السينما النظيفة»، المتمسّكة بقشور الأخلاق، ظنّاً من مطلقيها أن إنجاز أفلام خالية من القُبَل والعلاقات الحميمة والبحث في شؤون الجسد والعشق والجنس مثلاً، يحول دون سقوط المشاهدين في الفساد والمجون والانهيارات، ويحصّن أخلاقهم الرفيعة من الوقوع في شرك الشيطان الرجيم، متناسين الفساد والمجون المبثوثَين في السياسة والإعلام والاجتماع.
و«السينما النظيفة» هذه تعني، بالنسبة إلى منظّريها الأخلاقيين، أن هناك سينما أخرى «ملوّثة»، أي تلك المنشغلة بأمور يُعانيها الناس في حياتهم اليومية، والتي تُحارَب بسبب مناقشها هذه الأمور أو تسليط الضوء عليها أو التوغّل فيها؛ وتعني أيضاً أن هناك أفلاماً «وسخة»، أي تلك التي نزل صانعوها إلى عمق الحياة ومنعطفاتها وسلوك الناس فيها، تنقيباً في الأسباب المؤدّية إلى الفراغ والموت والعنف والكبت، ومعاينةً إبداعيةً للقمع وإمعان النظام البوليسي في هتك الأعراض، معنوياً ومادياً. ولأن «السينما النظيفة» سيطرت على شبكة واسعة من الإنتاج، ارتعد فنانون وفنانات عديدون أمام منظّريها الأخلاقيين هؤلاء، فانفضّوا عن مواجهتها والتصدّي لمشروعها التفتيتي الذاهب بالناس جميعهم إلى الانحطاط والظلامية والتخلّف، وعملوا فيها خوفاً من قوة غيبية، أو عجزاً عن إدراك الخطر المحدق بالمجتمع والناس والإبداع الناتج (أي الخطر) من خطاب التزمّت والرجعية، أو قبولاً بأي شيء لقاء الاستمرار بالعمل.
[[[
هناك تعبيرٌ آخر، «السينما الراقية»، استعاد تلك المرحلة السوداء من تاريخ السينما المصرية، المستمرّة في تفكيك بقايا البنى التحرّرية والإبداعية. فالسوء الطالع من مقولة «السينما النظيفة» وجد صداه في تعبير «السينما الراقية»؛ والانهيار الذي أصاب الإبداع البصري جرّاء تحكّم المقولة الأولى أعواماً طويلة في حركة الإنتاج السينمائي المصري، ازداد قوّة بـ«فضل» التعبير الثاني الذي عكس رغبة سياسية وثقافية واجتماعية ودينية في أن تخدم السينما إيديولوجيا إيمانية وخطاباً غيبياً، على النقيض التام للمعنى الأجمل للفن السابع، وللفنون كلّها: التحرّر الأقصى من أي قيد اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو حياتي في صناعة الإبداع، بالمحافظة على القواعد الإبداعية في صناعة هذه الفنون؛ وليس التقوقع في عزلة الجهالة، بتحويل الفنون إلى بيانات حزبية وترويجية وإيديولوجية، تخدم مفهوماً ما للأخلاق الحميدة.
إذا وُلدت الفنون من رحم التمرّد وتحطيم القيود والبحث عن المختلف في مقاربة أشكال الحياة وما بعدها، فإن السينما تُعتَبر أم الفنون الحاضنة أرقى مفرداتها التحرّرية وأنظف أنماط تعابيرها، بعيداً عن التفسير الإيديولوجي الغيبيّ الأعمى للرقي والنظافة.
السفير




