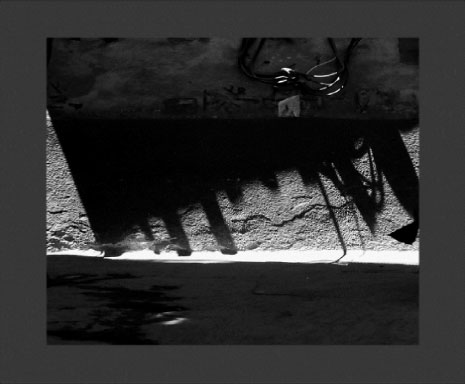إيليـــا توريـــن رامبـــو روســـيا: توفي في التاسعة عشرة وكان له معبودان: لينون وبرودسكي

ابراهيم استنبولي
وأنا أكسِّر الجليد بحالة نصف
هذيان في بلاط الليل,
سوف أخرج قريباً, على الأرجح,
عن سكة الدرب الدنيوي.
حين أنزل وحيداً (لا يُسمَحُ لاثنين)
إلى الأعماق –
فمن ذا الذي سيصبح ملاكي,
مَن الذي سيكون الإله؟
شاءت الأقدار أن يخرج إيليا تورين عن الدرب الدنيوي باكراً جداً – في التاسعة عشرة من العمر. ولد في 27 تموز من عام 1980 في موسكو, ورحل عن هذه الدنيا في 24 آب عام 1999 وهو في أوج تفتّحه الإبداعي. ومع ذلك فقد استطاع أن ينجز الكثير خلال سنوات عمره القصير. لقد أبدع إيليا في أجناس أدبية مختلفة بدءاً بالشعر, مروراً بالمسرح وانتهاء بالأغاني تأليفاً وأداء.
هذا ما يتضح من كتاب « الرسالة» الذي أصدرته والدته بالتعاون مع بعض الأصدقاء والذي يتضمن ما كتبه الراحل من قصائد بين عامي 1995 و1998, إلى جانب الراوية الشعرية «انفصام الشخصية», وكذلك لوحات من مسرحية غير مكتملة, وكلمات الأغاني والدراسات الفلسفية, إلى جانب المقالات النقدية ذات المضامين المتنوعة جداً: منها ما يتعلق بدراسة أشعار كل من توتشيف وبرودسكي ومندلشتام, وأيضاً رسالة إيليا تورين إلى «نبي روسيا المعاصرة» الراحل الكساندر صَلجِينتْسين (الحائز على جائزة نوبل للآداب)، وغير ذلك من المقالات الفلسفية والدراسات الاجتماعية.
لكن القدر لم يمنحه الوقت الكافي لكي يحقق جميع طموحاته.
كثيراً ما تناول موضوع الموت في كتاباته. فأن تكتب عن الموت – يعني أنك تفكر بالحياة. وهذا الموضوع يشكل عنصر جذب لكل من الفتوة والشعر.
«لن يأتي المستقبل من دوني» – كتب إيليا تورين في إحدى أغنياته.
كانت تسيطر عليه مشاعر متناقضة، للوهلة الأولى، لكنها في واقع الأمر قريبة ومترابطة مع بعضها البعض، من مثل الإحساس العميق بالنهاية وبالتخوم التي يليها غموض كامل، وكذلك إحساس لا يقل عمقاً بعلاقته بكل ما هو قائم وسيكون، وبالثقة في دوره الخاص، ولكن غير المتبلور بعد في تلك العملية التي تدعى «الحياة».
وأنت تقرأ مقالات الراحل تورين لا بد سيثير دهشتك نضجه المبكر، ذكاءه المميز، حماسه ومقدرته على التعبير الدقيق عن أفكاره.
كل شيء يثير اهتمامه: مستقبل «الوطن الحتمي»- كما يدعو روسيا، ومصير الجيل، وتارة يعلّق على مقالة كتبها أحدهم بخصوص قصة الكاتب الروسي الشهير غوغَل «المعطف». كما نجده يناقش بخصوص الطبع الروسي، ويكتب دراسة حول كتاب فيورباخ «جوهر المسيحية». وثمة مقالة فلسفية كتبها بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل يوسف برودسكي تتضمن أفكاراً مذهلة بعيدة عن أية توهّمات حول مصير الشاعر، لا يمكن إلا أن يندهش القارئ لحكمتها وبحيث لا يمكن التصديق بأن صاحبها فتى في السابعة عشرة من العمر.
والآن لنقرأ ما كتبته السيدة أ. ميدفيديفا في كتاب «الرسالة» حول ابنها الراحل:
كان وسيبقى شاعراً
« ونحو الساعة التاسعة
صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً:
إلهي، إلهي ! لماذا تركتني؟
إنجيل متى. لقد ولدتُ إيليا بتاريخ 27 تموز عام 1980 في الساعة العاشرة و24 دقيقة صباحاً. كان يوم أحد. وفي يوم السبت الذي قبله كنا أنا ونيكولاي (أبوه – المترجم) قد تمشِّينا طويلاً في حديقة اسماعيلوف في موسكو ورحنا نناقش الخبر المفاجئ الذي سمعناه عشية ذلك اليوم: توفي فلاديمير فيصوتسكي. أذكر أنه خطرت ببالي أثناء الحديث فكرة ما فحواها أن روسيا الآن قد بقيت من دون شاعر. بعد انقضاء خمس عشرة سنة، وأثناء حديثي مع إيليا (الذي كان قد تجاوز مرحلة الشغف الشديد بأغاني فيصوتسكي التي كانت تصدح في بيتنا باستمرار) قلت له بين المزح والجد: لم تستطع روسيا أن تبقى بلا شاعر لأكثر من يوم واحد. وها هو قد ظهر.
وقبل أن أنتهي من موضوع التطابقات سوف أشير إلى معبودين اثنين عند إيليا: يوسف برودسكي وجون لينون. الأول كان قد بلغ الأربعين من عمره في 24 أيار من عام 1980 – وسن الأربعين حد مميز، كما هو معروف بالنسبة للشعراء الروس. وقد كتب برودسكي في ذلك اليوم أبياتاً ستصبح من أحبّ القصائد لإيليا فيما بعد:
… ها قد بلغتُ الأربعين.
ماذا يمكنني أن أقول عن الحياة؟ تبين أنها طويلة جداً.
مع غصة فقط أشعر بالتضامن،
ولكن طالما لم يملأوا فمي بالطين،
فلن يخرج منه سوى الشكر والامتنان.
وفي أكتوبر من نفس العام سيبلغ لينون الأربعين ولكنه سوف يُقتَل بعد شهرين. وكان قائد الفرقة الموسيقية الأكثر شهرة في القرن العشرين (بيتلز) قد ألهَمَ إيليا لأن يؤسس فرقة موسيقية تحت اسم «صنبور إطفاء» ولكي يكتب الشعر الغنائي وأن يطلق ألبوماً باسم منتحل رائع «The Beatles again» يحتوي على أربع عشرة أغنية باللغة الإنكليزية.
إذن، ولد الطفل. كان لا بد من اختيار اسم له. سوف يكتب إيليا في أشعاره «الطفولية» حول ذلك ما يلي:
كانوا يريدون أن يسمّوه ميشيا
لكن أمّه الدقيقة في الحساب
وبعد أن تذكّرت البطل السلافي،
أطلقت عليه اسم إيليا.
و بما أن هذا هو المكان الوحيد الذي يرد ذكري في إبداع إيليا، فسوف أسارع للتوضيح: نعم، كان ثمة مثل هذا الافتراض… أن أسميه ميخائيل لأنه ولد في ذروة الألعاب الأولمبية في موسكو، وقد كان الدب ميشيا رمزاً لتلك الدورة. في الحقيقة لم يكن ثمة حساب في اختياري للاسم… لكنني وأنا في دار التوليد بعد ولادة الطفل مباشرة انتابني إحساس داخلي بأنه: سيكون إيليا وفقط إيليا! وفيما بعد فقط ربطت ذلك باسم البطل السلافي إيليا موروميتس لكي أهرب من الأسئلة الكثيرة التي واجهتها حول السبب في اختيار اسم يهودي صريح لابني في زمن لم تكن شائعة فيه مثل تلك الأسماء.
سأتجاوز الحديث – الشهادة عن طفولة إيليا الباكرة. والسبب أنه لا يوجد عندي أي تصور دقيق عن تلك الطفولة: فأنا لا أذكر أية «كلمات طفولية» نطقها إيليا، بل لم ينطق بمثلها بتاتاً. حتى إنني لا أتذكر أمراضه رغم أنها كانت موجودة لديه. الآن، وبينما أنا أراجع ذلك الشريط القصير من السنين، اكتشف أن سنواته كانت مزدحمة بالإبداع. فقد كان شعار الآباء المهووسين في سبعينيات القرن الفائت يعلن: «يجب على الطفل أن يتعلم السباحة قبل أن يمشي»… إلا أنَّ هذا لم يحصل لأنه كانت لدى إيليا (الناري) علاقة متوترة جداً مع الماء طوال الوقت. لكنه نجح بكل ما للكلمة من معنى في معادلة «أن يرسم قبل أن يمشي»…
بموازاة ذلك كان يقوم باستكشاف العالم… لم يكن إيليا يطرح الأسئلة من نوع «لماذا», بل كان يطرح أسئلة في صيغة أجوبة من نوع «السماء زرقاء لأنها…». وقد اختار في مسيرة إبداعه مساعداً اسمه الكساندر بوشكِن:
في سن الخامسة كان يفكر كثيراً،
إذ لم يعرف «معركة بَلْتافا » وحسب،
بل حتى أنه كان قد قرأها.
و بالتدريج صار يختار
درب الكاتب لنفسه…
كم باكراً كان يشعر بموهبته؟ أعتقد أن بلورة هذا الشعور لديه بدأت منذ الدقائق الأولى ولم تنقطع حتى آخر لحظة. وقد انعكست معاناته تلك في الكثير من قصائده:
إني أعرف موهبتي ـ وللقصيد المختصر
رحتُ أصلّي بنبرة حذرة،
وعشتُ، كما الصخَبُ في بيت مهجور،
كموجة في كأس حليب منسي…
لم يكن يجذبه التعليم الأساسي الرسمي الذي كان يمتاز بالجمود وبأنه وُضع ليناسب العقول غير الإبداعية… وبعد سبع سنوات من التعليم في مدرسة «إنكليزية» خاصة (في عام 1993) أنتج خيال إيليا الخصب والمتعطش للبحث حكايةً تاريخية من جنس الفنتازيا بعنوان «قلعتا آل لارسكاييه» يدور حول عصر مُتخيل يحاكي الميثولوجيا مع تسلسل إيرارشي للحكام ـ رواية شعرية على شاكلة «الكوميديا الإلهية» لدانتي، التي كان إيليا قد قرأها للتو… وقد أشار إلى ذلك بقوله فيما بعد: لقد كتبتُ روايتين شعريتين: «قلعتا آل لارسكييه» و«انفصام الشخصية»…
تم اتخاذ قرار بالتوقف عن الذهاب إلى المدرسة الرسمية. فقد كان بحاجة لوسط ثقافي وإبداعي مختلف. لذلك انتسب إلى معهد ملحق بالجامعة الروسية للعلوم الإنسانية. وعلى الفور تغير كل شيء: صار الفضاء أكثر اتساعاً، بدلاً من الجري منفرداً لمسافة قصيرة تمتد بين المدرسة والبيت، بدأت رحلات منتظمة يومية إلى حي سالانكا حيث يوجد المعهد أو إلى شارع البرافدا حيث المقر الرئيسي. راح إيليا يكتشف موسكو من تلقاء ذاته وراحت رحلاته في المدينة تطول أكثر وأكثر. ظهرت أماكن عزيزة بالنسبة له: شارع أرباط في المقام الأول. كما تعرّف على وجوه جديدة ونشأت لديه علاقات جديدة.
وفي هذه الفترة بالضبط يلتقي مع عدد ممن يشاطرونه الرأي ويقررون تشكيل فرقة موسيقية باسم «صنبور إطفاء»… فتجد موهبته الموسيقية والغنائية اعترافاً في المعهد، اعترافاً غير رسمي لكنه أعمق وأصدق من أي اعتراف آخر, حيث راحوا يتناقلون أشعاره ويستمعون إلى أغنياته، كما تم نشر قصيدته الطويلة التي كتبها تحت تأثير الأمسيات والمشاوير في شارع أرباط في المجلة الأدبية الدورية المخطوطة «وجوه».
ويقترب عام 1996، الذي ستندلق الأشعار فيه كما السيل العارم، لكنها كانت بحاجة لمصدر دفع وتحريض…
سبق وذكرت أكثر الشعراء قرباً لإيليا: بوشكِن، برودسكي، ومَنْدِلشتام فيما بعد… ولكل منهم تأثيره المختلف على إيليا. بوشكِن ـ المَثَل الأعلى والكمال. «بوشكِن ـ اسم مستعار للإله» ـ سيكتب إيليا يوماً ما وبذلك يقول كل شيء. مندلشتام – صوت الزمن الهش والتراجيدي في غير أوانه. أما قصائد يوسف برودسكي ـ مثل الخميرة بالنسبة لأشعار إيليا. كان إيليا سيكون شاعراً من دون يوسف برودسكي، لكنه صار شاعراً مع برودسكي بالضبط. مع أن «بركان» القصائد إنما بدأ بشكل حقيقي عند إيليا بعد وفاة برودسكي. كما لو أن الطبيعة استشعرت حدوث فراغ فحاولت ملؤه من جديد.
من دفتر يوميات إيليا:
13/ 01/ 96: قرأتُ اليوم برودسكي… وضبطتُ نفسي أقارنه مع ذاتي (لناحية القصائد). فعند برودسكي ثمة طيور في كل مكان، كما هو الحال عندي ـ مع الإلهة؟!! ثمة تشابه ما بيننا أنا والحائز على جائزة نوبل. يا لهول التفكير…
28 / 01 / 96: للتو عرفت أن برودسكي قد مات هذه الليلة، في نيويورك، أثناء النوم… منذ الآن، سوف أشعر بالرهبة في داخلي في كل مرة انطق بهذا الاسم، كما لو أنني أستدعيه للعودة سالكاً درباً غير بشرية…
29 / 01 / 96 أتوقف (مؤقتاً) عن التعاطي مع «اللاشيء», لأنني أريد أن أكتب شيئاً مكرّساً ليوسف برودسكي… نبشتُ الكتاب المقدّس بكامله وأخيراً وجدتها ـ «أحلام يوسف»… هكذا سوف أعنْوِنُ القصيدة.
31 / 01 / 96: لقد اختتم يوسف برودسكي كانون الثاني هذا وفي نفس الوقت بدأه في صيغة «أجزاء الكلام» (مجموعة شعرية لبرودسكي ـ المترجم) على طاولتي… إنه ـ في كل مكان، وهو يملأ كل ذرة الآن. وأنا أسعى لاستغلال هذه «الطاقة الذرية لبرودسكي»، لأن مثل هذه اللحظات تنقضي بسرعة. وهذا هو أول «حلم من أحلام يوسف» قد أصبح جاهزاً. انتظروه كما القنبلة الذرية.
29 / 02 / 96: هذا الشهر ـ شهرنا أنا وبرودسكي. لأول مرة أشعر بنفسي شاعراً بعد مرور عشر سنوات على كتابة أول قصيدة. هذا ـ في الخارج مني ؛ هذا ـ خارج الأربعة أرباع، التي لم يعد بإمكاني حشر نفسي فيها ؛ هذا ـ في الخارج ! قد يكون هذا – مجرد إيحاء ذاتي، لكنه على الأرجح – عَرَض. أشعر بالخضوع والإدمان على حاستي السادسة (والسابعة والثامنة وهلم جرا)، يجب (وأشدد على يجب) أن أكتب. وإلا فإني سأبقى إلى الأبد داخل المربع، داخل القرميد، هناك حيث «المرور ممنوع»…
1 / 03 / 96 ارسم نفسي باستمرار ـ كإنسان عظيم… كم كان الأمر رائعاً لو أنني أحمل معي دوماً «أجزاء الكلام»، وأن أجيب على الأسئلة بأنه «لطيف أن يكون لديك في جيبك ـ عالم آخر»…
لكن عام 1996 يجلب معه أولى الخيبات. إذ اشتعلت عند إيليا فجأة حمى النشر ـ في مجلة أدبية مرموقة! وقد كنت أنا المسؤولة عن ظهور هذه الحمى، انطلاقاً من علاقاتي الواسعة مع «الوسط الأدبي» وما رافق ذلك من توهمات لدّي. باختصار، بعد أن أطلع رئيس تحرير مجلة أدبية معاصرة تهتم بنشر أشعار برودسكي على مختارات من قصائد إيليا، قال لي: «سوف ننشرها»! وطلب مني صورة لإيليا وقام بدعوته لحضور أمسيات شعرية في البيت المركزي للأدب، لكنه لم ينشر شيئاً… نفس الشيء تكرر مع صحيفة أخرى تربطني صداقة مع إدارة تحريرها. حيث وعدوا بنشر القصائد وطلبوا كتابة مقدمة. وهذا ما فعله إيليا وإنْ بعد طول تردد. لكنهم لم ينشروا أية قصائد. إذ تبين أن «المسؤول» عن الصفحة الثقافية في الجريدة لا يطيق سماع اسم برودسكي. والمختارات كانت، بالطبع، تبدأ «برؤى يوسف»…
بعد ذلك بدأت مرحلة من العدمية عند إيليا… إذ أن الفشل في نشر أشعاره ـ وهذا أمر طبيعي بالنسبة لأي شاعر مبتدأ ـ دفعه للتوقف عند مسألة جديدة: وما هو الفكر الاجتماعي بالضبط، وأين تكمن قوته وضعفه؟… فيبدأ نشاطه كصحفي ـ حيث يكتب وينشر دراسات ومقالات حول بعض المسرحيات ويقوم بزيارة بعض المعارض والصالونات الموسيقية. أي أنه راح يدرس الموضوع من الداخل. وبعد مرور عام تحولت تلك الملاحظات والتحقيقات إلى أول لبنة في الشروع لكتابة عمل رئيسي بعنوان: «ميكانيكا الفكر الاجتماعي»…
و فجأة يقرر إيليا أنه سيصبح طبيباً لأنه يرى في الطب جانباً فلسفياً ولأنه «أريد أن أساعد الناس وأعرف كيف». ولكنه يتساءل: وهل الطب مهنة مناسبة للرجل؟
شعرتُ بإحباط لا حدود له: فكل شيء كان يسير في اتجاه أنني: أمُّ شاعر ! وفجأة هذا الانقلاب المباغت. وإيليا إذا ما قرر شيئاً فسوف يفعله بلا تردد. ففي سن الثامنة اتخذ قراراً بالانسحاب من مدرسة الفنون لأنه اعتبر سفرَ مدرّسيه إلى إسرائيل « خيانة « بالنسبة له. وبنفس الطريقة يغادر فرقة « صنبور الإطفاء « بعد أول وآخر حفلة جماهيرية في 18 آذار من عام 1996: والهدف التفرغ كلياً لكتابة الشعر.
يسعى إيليا جاهداً للدخول إلى الأكاديمية الطبية الروسية (معهد سيتشينَف) لكنه يفشل في امتحان القبول. فيبدأ البحث عن عمل. مما يضطره للعمل في معهد (سكليفوسوفسكي) للإسعافات الأولية. فكدت لا أعرف ابني: يستيقظ في السابعة صباحاً ليصل المعهد في التاسعة حيث يبدأ عمله وهو توزيع الأدوية على المرضى، ليعود في الخامسة بعد الظهر. (ومن خلال الأحاديث القصيرة حول مائدة الغداء سمعت لأول مرة « بالعجائز « اللاتي نسينَ منذ زمن بعيد كل ما له علاقة بالعلم، وبقصة المستخدم – « النقّال » – الذي « لا وجه له «والذي» ألْهَمَ «إيليا تأليف « أغنية المُستخدَم»).
و ماذا عن الأشعار؟ لا أشعار جديدة. فبعد لوحات « شكسبيرية « مدهشة كان قد كتبها في دفتر يومياته مباشرة بدون مسودة خلال يومين فقط (للعلم فقط، كان إيليا يقرأ شكسبير وبايرون باللغة الإنكليزية ويعرب أحياناً عن « عدم رضاه » عن ترجمة بَسْتِرناك لأنها لا تطابق الأصل…) – الصمت وحده سيد الموقف. وعند سؤالي « ألن تكتب الشعر بعد؟ »، كان يجيب مازحاً « في حال طلب مني أحد ما من باب الصداقة… ». ولكنني بعد عام ومصادفة اكتشف بين أوراقه قصيدة مكتوبة بعنوان « النهاية »: فيها يودّع إيليا الشعر بقسوة. مع أنه سيكون ثمة «خلجات» شعرية فيما بعد. إذ سأجد في دفتر يومياته بقايا لمجموعة كاملة من القصائد الفلسفية، لكن قصيدة « النهاية Final» ستكون لحد ما ـ آخر القصائد. « لقد جفّ ينبوع أشعاري السحري منذ زمن بعيد » ـ سيكتب إيليا في حزيران من عام 1999.
اليوم الأخير
24 آب من عام 1999 أيقظتُ إيليا باكراً: كان عليه أن يصل إلى حي ستْراغينو في موسكو عند الساعة العاشرة. كما كان عليَّ أن أقوم ببعض الأعمال التحريرية. تناولنا الفطور سوية. كان إيليا عابثاً يميل للصمت. ثم لبس ثيابه وجمع أغراضه بسرعة، علّق الجيتار الكهربائي عبر كتفه، نظر في المرآة – ما زالت هذه «اللقطة» راسخة في مخيلتي – ثم اتجه نحو الباب الخارجي. مشيتُ وراءه: «متى ستعود؟». رمى وهو عند الباب: «متى؟.. سوف أتأخر…» ـ وذهب في اتجاه المصعد.
لتعاستي، لم أكن مع إيليا في يومه الأخير ولم أرَ إيليا بعد تلك الدقيقة.
و لن أعرف أبداً ماذا حدث بالضبط في تلك الفترة الممتدة بين الساعة الثامنة والتاسعة من ذلك اليوم الأليم.
كما روى لي صديقه بيتر(بطرس)، قررا أن يقطعا مسافة معينة سباحة في منطقة تسمى «خور النهر» (يا له من اسم !) من نهر موسكو. لم يكن إيليا ماهراً في السباحة، لكن روح الشاعر المتحمسة التي أقنعت ذاتها والآخرين بأنه يتقن ذلك بصورة ممتازة أبت أن تتراجع.
« لقد كان إيليا سعيداً تماماً آنذاك. وقد يكون هذا جعله ينسى الخطر » ـ ستقول لي فيما بعد والدة زميله بيتر. وأنا أثق بكلامها: إذ أن إيليا أمضى يومه الأخير في بيتها. ولاحقاً أقرأ في كتاب عن فرقة « بيتلز » كلمات مدير أعمال لينون: « لم أر في حياتي جون لينون سعيداً كما كان في آخر يوم من حياته ». وأنا من جديد أحني رأسي أمام حتمية المصادفات…
رسالة
دعوا كل شيء. دعوا كل ما هو موجود:
خلفنا، فينا، فوقنا، أمامنا.
دعوا كل شيء: كما الموسيقى،
كما هو ثأر الزجاج القاسي
من إطار النافذة.
دعوا كل شيء. دعوا الضوء أولاً ـ
في كل تجلياته: في الشموع
و خلف الشموع،
و خلف أولئك الذين ليسوا موجودين،
و لكن ـ يجب الاعتقاد، أنهم سيكونون.
دعوا كل شيء. دعوا اليوم ـ للعيون،
و نهايته ـ للشفاه التي قالت « آمين ».
دعوا الليل: فهو سيتذكركم،
و قد نسي ذاته الممتلئة بكم.
و كل شيء سوف يبقى.
و فقط الساعة، وهي تعدو بسرعة إلى الأمام،
سوف تهمس: ألفا، بيتا…
اوميغا. انتهى.
دعوا التوقيع ـ
و دعوا الضوء.
لكن لا تطفئوا النور.
1996
صنبور إطفاء
و أنت تمشي في شارعٍ باسم السماء،
تشاهد ركنَ كلِّ القديسين،
حيث دقَّ مسماران أعوجين صدئان،
و عليهما قد علِّق بيتي الوحيد.
أحيا سعيداً في ذلك البيت،
مع أن العفش مجرد خرطوم لا أكثر.
بيتي ـ صندوق أحمر على حائط أبيض،
بيتي ـ صنبور إطفاء.
حين أعود من العمل، أندس
عبر الباب المفتوح بصعوبة بالغة جداً.
لن يدرك أحد مهما حاول أن يقيس بالمتر
كم هو فسيح بيتي ـ الصندوق الأحمر.
أحيا سعيداً في ذلك البيت،
مع أن العفش مجرد خرطوم لا أكثر.
بيتي ـ صندوق أحمر على حائط أبيض،
بيتي ـ صنبور إطفاء.
1994
بلا عنوان
…
…
لا يمكن أن نتذكركم غيابياً،
يا أحياء الطفولة. فالبيت بالنسبة للعابر
صار يعادل الحزن، لأنه يعرف فيه
كلا المدخلين:
الأول الرئيسي، يُشَاهد رويداً،
كما لو أن فيه ألم مذ كان جنيناً –
لكن الشيء ذاته يتحول إلى ألم،
عندما يكون بإمكاننا التنبؤ بالباب الثاني.
مختصراً وضع الأساس في ذاته
و مختتماً البيت بالباب ـ
هو يدخل الذاكرة جانباً، كما الأعمى
الذي يبحث عن عصاه.
لا تنهض: لقد جئتُ مع القصائد،
إنها لأجل السمع واليدين.
ليس النغم ما يموت. بل نحن ـ نهمد ـ
و نموت. يا لها من حلقة رقائقية.
لأنه ـ هل ستفهم؟
ليس ثمة من سؤال عند الموت:
« إلى أين سأصل »؟،
و ليس ثمة من أرض:
الإله فقط أو الأبالسة،
الجنة فقط أو جهنم. ونحن في جهنم.
فالموت ـ ليس موظفاً إدارياً
و هو لا يوزع المفاتيح:
فالكل موتى. بل هو منظِّم
لدرجة الصوت. إذا كنت تريد – فأدره.
كم مدهش، كيف إننا نحرك
الأدوات بحماس !
و من بينهم ـ ذاك أيضاً.
الطقس يسوء. يتساقط الثلج،
فهيا ساعدني.
(كاتب سوري)
إعداد وترجمة/ إبراهيم إستنبولي
السفير