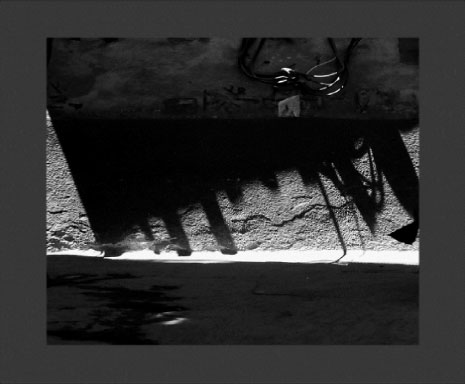أرى اللامعنى في كل شيء

أن يُعرف شاعر بعد مماته، وينال شهرة واسعة، ليس مثاراً للدهش. فقد عرف كثيرون هذا المصير. أما ان يصبح هذا الشاعر في إثر رحيله، شاعراً قومياً، فمدعاة للتساؤل. ولكن، هذا ما حدث لفرناندو بسّوا (1888 – 1955). أما إذا ما عرفنا أن بسّوا هو ابن البرتغال، فإن مثل هذا المصير المستغرب، لا يعود مستغرباً، حيث من تقاليد هذا البلد، اعتبار الشعر كأسمى تعبير عن الوجه القومي. عاش بسّوا وحيداً ومتنقلا بين الفنادق الرخيصة وغرف للأيجار. لم ينشر في حياته إلاّ في الصحف والمجلات، وبعض الكتيبات الشعرية بالانكليزية، ومجموعة شعرية واحدة، عنوانها “رسالة”. أعماله غير المنشورة التي تركها، توضح مغامرته الذهنية الكبيرة التي رأى فيها البعض نوعاً من الاشراق، وآخرون نوعاً من الخداع: خلْقه مثلا ثلاثة بدائل له، ومنحها هوية، وسيرة حياة، وأسماء، وأحاسيس، وأساليب مختلفة. وهم: ريكاردو رييس، عالم بالآداب القديمة، رواقي، مولع بالشكل الدقيق. ألفارو دي كامبوس، مدّاح لقوى العصر، والآلة، والسرعة، وهو سابق لبعض التيارات الرئيسية، كموضوع الغربة، والعبث. والبديل الثالث ألبرتو كاييرو الذي يعتبره الأولان معلماً لهما. إنه ابن الطبيعة، وثني، حِسّوي، محرر من الوهم، لا يضع شيئاً خارج الرؤية والواقع، مضادّ للرومنطيقية، مضادّ للفلسفة. يمكن اعتباره أول الوجوديين، مع ميل الى التكرار والإصرار في أسلوبه البسيط وغير المعقد، ولكن المحمّل الأسئلة.
في رسالة الى أحد الأصدقاء يرى بسّوا، أن الفن عنده، هو تعبير عن فكرة، من خلال انفعال، او بعبارة أخرى، عن حقيقة عامة، من خلال خداع معيّن (والخداع هو الادهاش في مفهوم بسّوا). لا يهم ان نشعر بما نعبّر عنه. يكفي أن نفكّر فيه، حتى نبدو كأننا نشعر به فعلا. من الممكن ألا يكون شكسبير أعظم شاعر في كل الأجيال، إذ ليس من الممكن، كما بدا له، أن نقدم أحداً على هوميرس. لكن شكسبير هو المعلم الأكبر للتعبير في العالم أجمع، والأكثر خداعاً بين جميع الشعراء، لأنه بهذه الصفة قد عبّر بتميز معادل عن كل أوجه الشعور والوجود. وعن مختلف الحالات النفسية. وهي حقائق إنسانية تمكن شكسبير من التصدي لها. بالنسبة اليه (اي بسّوا) اذاً، الفن في أساسه درامي. والفنان الأعظم سيكون ذاك الذي يقدر أن يعبّر دراميا، بطريقة أعقد وأوسع وأكثف عن كل ما لا يحسّ به، أو بصيغة أخرى، عن كل ما لا يحس به إلا لكي يعبر عنه. بسّوا شاعر نسيج وحده. يكشف نتاجه عن نزاع درامي بين الاحساس والعقل، حيث يصعب الفصل بين الشاعر والمفكر في شخصه. ولعل هذه الدرامية هي وراء تحرره من إسار السلبة. ولعل العائق الأهم أخيراً، الذي حال دون طبع أعماله في حياته ما جاء في مؤلفه النثري “كتاب اللاطمأنينة”: “إن إنجازي عملا من الأعمال الابداعية، ثم اكتشافي مساوئه بعد ذلك، لهما من مآسي الروحية الكبرى، وبخاصة حين اكتشف أن ذلك العمل هو أفضل ما استطعت إنجازه. لكن لجوئي الى كتابة عمل معيّن، مع معرفتي المسبقة بأنه لا بد أن يكون ناقصاً وفاشلا، بل وملاحظتي ذلك أثناء الكتابة، لهو أقصى حالات التعذيب والاذلال الروحي. انا لا أحس بعدم الرضا عن الأشعار التي عليّ أن أكتبها ولن تحظى برضاي بدورها، بل أدرك ذلك فلسفياً وجسدياً. لماذا أكتب اذاً؟ لأنني أنا الذي يدعو الى التنازل والانسحاب، لم أتعلم بعد ممارسة هذا التنازل على أكمل وجه. لم أتعلم التخلي عن التوق الى الشعر والنثر. عليّ أن أكتب كما لو كنت أنفّذ عقاباً. والعقاب الأكبر هو معرفتي أن ما أكتبه باطل وفاشل وغير يقيني”.
من شعر البديل ألبرتو كاييرو
-1-
ما نرى من الأشياء، هو الأشياء.
لماذا نرى شيئاً ما، إن كان يوجد آخر؟
لماذا يكون فعل الرؤية والسمع وهماً،
إن يكن السمع والرؤية حقاً هما سمع ورؤية؟
الجوهري أن نُحسن الرؤية،
أن نُحسن الرؤية بدون تفكير،
أن نُحسن الرؤية عندما نرى،
بدون أن نفكّر عندما نرى،
ولا أن نرى عندما نفكّر.
لكن ذلك (يا لتعاستنا نحن الذين ينتحلون روحاً!)
يتطلّب دراسة معمّقة،
وتدرّباً علمياً كاملاً على نسيان ما حفظنا،
وانحباساً في حرية ديرٍ يرسم فيه الشعراء
النجوم كراهباتٍ خالدات،
والأزهار كتائباتٍ زائلاتٍ بسرعة بقدر ما هنّ قانتات،
بينما النجوم في الأخير ليست سوى نجوم،
والأزهار سوى أزهار،
ولذا نحن نسمّيها نجوماً وأزهاراً.
-2-
إن شاؤوا أن تكون لي صوفية، فليكن.
أنا صوفي، ولكن مع الجسد فقط.
نفسي بسيطة ولا تفكّر.
صوفيتي هي في رفض المعرفة.
شأنها أن تعيش ولا تفكّر.
أجهل ما هي الطبيعة: أغنّيها فقط.
أعيش على رأس تلّة
في منزلٍ منعزلٍ ومطليّ بالكلس الأبيض.
ذلك ما يحدّدني.
-3-
أرى من الطبيعي جداً أن لا نفكّر،
أن أنفجر بالضحك وحدي أحياناً،
لا أعرف لماذا، ولكن لأمرٍ له علاقة
بأنّ ثمة أناساً يفكّرون…
وجداري، ماذا يمكن أن يفكّر في ظلّي؟
أسأل نفسي أحياناً، الى أن أتبيّن
أنّي أطرح على نفسي أسئلة…
إذذاك أنزعج وأحسّ بضيق
كما لو تبيّن لي أنّي ذو قدم باردة…
ما يمكن “هذا” أن يفكّر في “ذاك”؟
لا شيء يفكّر في لا شيء.
هل تشعر الأرض بالأحجار والنباتات التي تحملها؟
إن تكن تشعر، حسناً، لتكن!
ما يهمّني أنا؟
إذا فكّرت في هذه الأشياء،
سأكفّ عن رؤية الأشجار والنباتات،
وعن رؤية الأرض،
لأرى فقط أفكاري الخاصّة…
وسأغرق في الحزن وفي الظلمة.
لكنني، والحال هذه، بدون تفكير، أملك الارض والسماء.
-4-
لا أبالي بالقوافي. قلّما تتشابه شجرتان متجاورتان.
أفكّر وأكتب كما تكتسب الأزهار ألوانها،
لكن طريقتي في التعبير أقلّ كمالاً،
حيث تعوزني البساطة الإلهية
في أن أكون خارج ذاتي تماماً ولا شيء أكثر.
أنظر وأنفعل.
أنفعل كجريان الماء في منحدر.
وشِعري طبيعي كهبّة ريح.
-5-
بطريقة أو بأخرى،
وفقاً للصواب أو لا،
وقدرتي على قول ما أفكّر فيه،
وقوله أحياناً برداءة أو بطريقة مغلوطة،
فأنا أكتب أشعاري بدون تعمّد،
كما لو ان عمل الكتابة ليس من صُنع إشارات،
كما لو أن فعل الكتابة يحدث لي
كمن يأخذ حمّام شمس.
أسعى الى قول ما أعاني
من دون أن أفكّر في ما أعاني.
أسعى الى تطبيق الكلمات على الفكرة،
وألاّ أحتاج الى مجاز الفكر
ليفضي بي الكلام.
لا أتوصّل دائماً الى معاناة ما أعرف
أنّ عليّ معاناته.
لا يجتاز تفكيري النهر سباحةً
إلاّ في بطءٍ شديد،
لأن اللباس الذي فرضه عليه الناس يثقل عليه.
أحاول أن أتجرّد مما تعلّمت،
أعمل على نسيان نمط التفكير الذي أرسخوه في ذهني،
على مَحْو الحِبر الذي لطّخوا به حواسي،
على إطلاق مشاعري الحقيقية،
على نزع ما يغلّفني، وأن أكون ذاتي – وليس ألبرتو كاييرو،
ولكن حيواناً بشرياً من صُنع الطبيعة.
وها أنذا أكتب الآن، وبي توقُ الى
الاحساس بالطبيعة، لا كإنسان حتى،
بل كمن يحسّ بالطبيعة لا غير.
وهكذا أكتب، فأجيد حيناً وأخفق حيناً،
وحيناً أُدرك بسهولة ما أريد التعبير عنه، وحيناً أضلّ،
فأسقط هنا، وأنهض هناك،
ولكنّي أتابع دائماً طريقي كأعمى عنيد.
ما هَمّ… فبرغم كل شيء أنا فردٌ من الناس.
أنا مكتشف الطبيعة.
أنا مغامر الاحاسيس الحقيقية.
أحمل الى العالم عالماً جديداً،
لأني أحمل الى العالم العالمَ بالذات.
هذا ما أحسّه وما أكتبه،
عارفاً تماماً وبدون إلقاء نظرةٍ حتى،
أن الساعة هي الخامسة صباحاً،
وأن الشمس وإن لم تُطلّ بعد برأسها
من فوق جدار الأفق،
فإننا نتبيّن أطراف أصابعها
وهي تمسك بأعلى جدار الأفق
المليء بالجبال المنخفضة.
-6-
لا يكفي أن تفتح النافذة
لترى الحقول والنهر.
لا يكفي ألاّ تكون أعمى
لترى الأشجار والأزهار.
يجب ايضاً ألا تكون لك أي فلسفة.
مع الفلسفة ليس من أشجار: ليس سوى أفكار.
ليس سوى كل منا، اشبه بكهف.
ليس سوى نافذة مغلقة، وكل العالم في الخارج،
والحلم بما كان يمكن أن نرى لو أن النافذة انفتحت، ولم يكن قط ما نرى عندما تنفتح النافذة.
-7-
بين ما أرى في حقل وارى في حقل آخر
يمر في لحظة شبح رجل.
وتمضي “معه” خطاه، في الواقع نفسه،
لكنني ألاحظ انهما، هو وخطاه، شيئان منفصلان:
“الرجل” يسير مع أفكاره، بُطله بقدر غرابته،
والخطى تمضي مع النظام القديم الذي يحرك ساقيه.
انظر اليه من بعيد بدون أي رأي.
كم هو كامل في ذاته بما هو – جسده،
واقعه الحقيقي الذي لا رغائب له ولا آمال،
بل عضلات لاستخدامها بطريقة عادية وأكيدة.
-8-
المرء الذي يكرز بحقائقه
جاءني امس ايضاً ليتحدث اليّ.
حدّثني عن آلام الطبقات الكادحة
(وليس عن الكائنات التي تتألم، مع الأخذ في الحسبان المتألمين الحقيقيين)
حدّثني عن الظلم الذي يجعل البعض يملكون المال،
والآخرين جوعى – جوعى الى الطعام
او جوعى الى حلوى الآخرين، لا اعرف ما اقول.
حدّثني عن كل ما يثير غضبه.
كم هو سعيد، من يستطيع أن يفكر في شقاء الآخرين!
وكم هو غبي، إن يكن يجهل ان شقاء الآخرين ليس سوى ملكهم،
ولا يشفى من الخارج،
لأن التألم لا يعني الحاجة الى حبر
او لأن الخزانة تفتقر الى صفائح حديد!
ان واقع الظلم كواقع الموت.
بالنسبة اليّ!، لن اقوم بخطوة، حتى أغيّر ما نسمّيه ظلم العالم.
وإن الف خطوة أخطوها في هذا الاتجاه،
لن تشكل سوى الف خطوة اضافية.
إني اقبل الظلم كما اقبل حجراً غير مستدير،
او أن لا تكون بلوطة فلّين ولدت صنوبرة أو سنديانة مثمرة.
لقد قطعت الليمونة نصفين، وجاء النصفان غير متساويين،
فأيهما ظلمت – انا الذي سيأكل الاثنين معا؟
-9-
انت ترى، ايها الصوفي، معنى في كل شيء.
كل شيء، بالنسبة اليك، له معنى محجوب.
ثمة شيء خفي في كل ما تراه.
وما تراه، تراه دائما بغية ان ترى شيئا آخر.
بالنسبة اليّ، بفضل الواقع لي عينان تريان فقط،
ارى اللامعنى في كل شيء،
ارى ذلك وأحبّني، لأن كونه شيئا
لا يعني شيئا.
وكونه شيئا، لا يعني ان يكون قابلا للتأويل.
-10-
الحقيقة المرعبة للأشياء
هي اكتشافي لكل الأيام.
كل شيء هو ما هو،
ويصعب أن أوضح كم يفرحني ذلك
وكم يكفيني.
يكفي أن أوجد لأكون كاملاً.
كتبت عددا كبيراً من القصائد.
سأكتب بعد، بالطبع.
وهذا تعلنه كل واحدة من قصائدي،
وكل قصائدي مختلفة،
لأن كل شيء في العالم يتحدّث
عن العالم بطريقته.
احياناً أحدق الى حجر.
لا افكر أن يكن يحس.
لا يغويني ان ادعوه اخي،
بل أحبه لأنه حجر،
أحبه لأنه لا يعاني شيئاً،
أحبه لأن لا قرابة تجمعني به.
احياناً اسمع مرور الريح،
وأجد ان لا شيء يستحق عناء أن نولد
لأجله، سوى سماع مرور الريح.
لا أعرف ما سيفكر فيه الآخرون عند قراءة هذا القول،
لكني أجده حسناً لأني افكر فيه بدون جهد،
وبدون تصور ان ثمة غرباء كي يسمعوني افكر:
لأني افكر فيه خارج كل تفكير،
لأني اقوله كما تقوله كلماتي.
مرةً سمّوني شاعراً مادياً،
ودهشت لأني لم أكن اتخيل
انهم سيمنحونني اسماً.
انا لست حتى شاعراً: اعرف ذلك.
إن يكن لما اكتب من قيمة، فأنا لا املكها:
القيمة هناك، في اشعاري.
وكل ذلك مستقل تماما عن ارادتي.
(من مجموعة: راعي القطعان)
(من مجموعة: مكتب التبغ)
من شعر البديل ألفارو دي كامبوس
ذلك القلق القديم
ذلك القلق القديم
ذلك القلق الذي أحمله منذ اجيال،
لقد طفحت به الكأس
دموعاً، تخيلات هائلة،
احلاماً كابوسية غير مخيفة،
ومشاعر عظيمة مفاجئة وخالية من كل معنى.
لقد طفحت الكأس.
اكاد اعرف كيف أتصرف في الحياة
مع هذا الضيق الذي أحدث لي تجاعيد في النفس!
لو أصبحت على الأقل مجنوناً حقاً!
ولكن لا: فهذا الحائر،
هذا الشبه،
هذا الممكن، هذا الربما…،
هو كذا.
إن محتجزاً في ملجأ، هو على الاقل شخص ما.
انا محتجز في ملجأ بلا ملجأ.
انا مجنون بلا احساس،
انا واع ومجنون،
انا غريب عن الجميع وندّ للجميع:
أنام يقظاً بأحلام جنونية
لأنها ليست أحلاماً
أنا كذا…
يا منزل طفولتي البائس القديم طفولتي الضائعة!
من قال لك إني كنت قليل الحفاوة بنفسي!
أين هو ابنك؟ لقد أضاع رشده.
أين من كان يرقد في سلام تحت سقفك الريفي؟
اين هو من كنتُه؟ لقد اضاع رشده. هوذا ما أنا اليوم.
لو كانت لي فقط ديانة ما!
لنذكر مثلاً ذلك “الفتيش” في المنزل،
والمجلوب من افريقيا،
كان جد قبيح، وجدّ مضحك،
ولكن في داخله كانت تكمن الوهية كل ما نؤمن به.
ليتني كنت استطيع أن اؤمن بفتيش ما –
جوبيتير، يهوه، الأنسانية –
لا يهم، أي من هذه الأسماء مناسب،
إذ ماذا يعني الجميع سوى ما نتصوره عن الجميع؟
فانفجرْ إذاً، يا قلب الزجاج الملوّن!
عيد مولدي
زمان كنا نحتفل فيه بعيد مولدي،
كنت سعيداً، ولم يكن مات أحد بعد.
في المنزل القديم، كان حتى عيد مولدي
تقليداً عريقاً،
وكان فرح الجميع، وفرحي، أمراً ثابتاً كديانة ما.
زمان كنّا نحتفل فيه بعيد مولدي،
كنت اتمتع بتلك الصحة التامة التي تقوم على عدم فهم شيء،
وأن اكون ذكياً في نظر العائلة،
وألا تكون لي سوى الآمال التي يتعلل بها الآخرون.
تلك الآمال التي كنت، حين اخفق في نيلها، لا أعرف قطعاً أن اتعلّل بها.
وعندما أخذت أتأمل في الحياة، كنت اضعت معنى الحياة.
نعم، ذلك ما كان يُفترض أن اكونه،
ذلك ما كنته من حيث الشعور والقربى،
ما كنته من سهرات شبه ريفية،
ما كنته طفلاً ومحبوباً من الآخرين،
ما كنته – آه يا إلهي! الآن فقط أقول إنيّ أعرف ما كنته…
كم يبعد ذلك!…
(لا اذكر حتى…)
زمان كنا نحتفل فيه بعيد مولدي!
ما أنا اليوم اشبه برطوبة الممشى
في مؤخّر المنزل،
التي تبث جراثيم العفونة في الجدران…
ما أنا اليوم هو الواقع الذي أسفر عن بيع المنزل،
وعن موت الجميع،
وبقائي وحيداً كعود كبريت بارد.
أرى ماضيَّ بوضوح يجعلني عميّاً عن الأشياء الحاضرة…
المائدة المعدّة بكل اغطيتها، بكل ادواتها المزينة
بأجمل الرسوم، بكل اقداحها،
وخزانة الأطباق بمختلف أشيائها – من حلويات، واثمار،
وما تبقّى مخفيّ في أعلى الخزانة.
والعمّات العجائر، وجميع ابناء العم، الذين أتوا من أجلي،
زمان كنا نحتفل فيه بعيد مولدي…
فتوقّف، ايها القلب!
لا تفكّر! دع الفكر في الرأس!
يا إلهي! يا إلهي! يا إلهي!
اليوم لم يعد لي عيد مولد.
أنا استمر.
أيامي تتلاحق.
سأشيخ في الوقت المقدّر.
هذا كل شيء.
لكن غضبي شديد لأني لم أحمل في جيبي ذلك الماضي المختلس…
زمان كنا نحتفل فيه بعيد مولدي!
كل رسائل الحب…
كل رسائل الحب
مضحكة.
وهي ما كانت لتُسمّى رسائل حب
لو لم تكن مضحكة.
أنا أيضاً في شبابي كتبت رسائل حب،
مثل الآخرين،
مضحكة.
أن رسائل الحب، إنْ وُجد الحب،
هي حتماً
مضحكة.
ولكن، بعد كل حساب،
ليس مضحكاً
سوى الذين لم يكتبوا رسائل حب.
آه، لو أسترجع الزمان الذي كنت أكتب فيه
لاشعورياً،
رسائل حب مضحكة…
الحقيقة أن ذكرياتي اليوم
في رسائل الحب تلك
المضحكة.
(كل الكمات المفخَّمة
مثل المشاعر المفخّمة
هي طبيعياً
مضحكة.)
نشيدان للبديل ريكاردو رييس
-1-
سعداء أولئك الذين ترتاح أجسادهم في الثرى تحت الأشجار،
الذين لا يعانون أذى الشمس، ولا يعرفون شيئاً عن الانفعالات القمرية.
ليُفرغ إيول كهفه بكامله
على هذه الكرة الممزّقة،
وليرفع نبتون بملء يديه
عاصفة الأمواج.
كل ذلك ليس بشي، والراعي نفسه
الذي يمرّ عند غروب الشمس
تحت الشجرة حيث يرقد من كان ظلاً
ناقصاً لأله،
يجهل أن خطاه تغطّي
ما كان يمكن أن يكون ربما،
لو ان الحياة كانت دائماً الحياة،
ومجدَ جمال أزليّ.
-2-
في هذه الحفرة التي أنحني فوقها
لا وجود، تقول لي، للشخص المحبوب…
لا ضحك ولا بصَر في هذه الرقعة المربّعة من التراب…
آه! ولكن هنا تتوارى شفتان وعينان.
وأنا كنت أشدّ على يدين، وليس على روح.
وهاتان اليدان ترقدان هنا.
فيا صديقي، أنا أبكي على جسد!
(من “أناشيد”)
(F. Pessoa, le gardeur de troupeaux, NRF
F. Pessoa, Bureau de tabac, NRF)
فرناندو بسّوا
( التقديم والترجمة: هنري فريد صعب)