فصل من “كتاب الشاي” لـ”أوكاكورا كاكوزو””
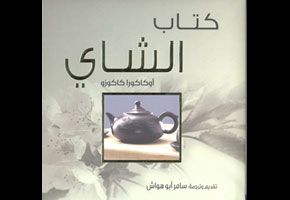
.I كوب الإنسانية
قبل أن يصبح الشاي شراباً، كان عشبة طبية إلى أن أدخلته الصين في القرن الثامن ميلادي، إلى مملكة الشعر، بوصفه واحداً من المتع الكيّسة. أما القرن الخامس عشر فقد شهد رفع اليابان للشاي إلى مصاف المذاهب الجمالية الراقية، لينشأ بعدئذ ما يمكننا تسميته مذهب “الشايّية” Teasim . وقد انبثقت “طائفة” الشاي من صلب تقدير سموّ الجمال في خضمّ الحقائق الدنيئة للحياة اليومية. وهي “طائفة” تحتفي بالنقاء والتناغم، وبسرّ الكرم المتبادل، وبرومانسية النظام الاجتماعي. وهي تجسّد بالضرورة عبادة للنقصان، كما أنها محاولة رقيقة لإنجاز ما أمكن في خضمّ هذا المستحيل الذي نسميه الحياة.
ولا تمتّ فلسفة الشاي بصلة مباشرة لعلم الجمال بالمعنى المألوف لهذا التعبير، إذ أنها تختزل، فضلاً عن الأخلاق والدين، وجهة نظر متكاملة عن الإنسان والطبيعة. وهي فلسفة مرتبطة بالنظافة، بما أنها تحثّ عليها؛ وهي تُعنى أيضاً بالاقتصاد، إذ تجد أرضيّة لها في البساطة أكثر مما في التعقيد والتكلّف؛ وهي هندسة أخلاقية، بوصفها بوابة أخلاقية لإحساسنا بالتناسب في هذا الكون. وهي تمثّل الروح الحقيقية للديمقراطية الشرقية إذ تجعل جميع مريديها أرستقراطيين لجهة الذوق.
لقد لعبت العزلة الطويلة التي عاشتها اليابان بعيداً عن بقية أنحاء العالم، بوصفها سبباً لتأمل الذات وسبر أغوارها، دوراً أساسياً في تطوّر “الشايية”. إن منازلنا وعاداتنا، أزياءنا ومطابخنا، فنون البورسلان والشراب والتزيين والرسم، وحتى أدبنا نفسه، كانت جميعها عرضة للتأثر بهذا العلم، حتى أنه ليس من دارس للثقافة اليابانية يسعه تجاهل حضور الشاي فيها. لقد طاول هذا العلم تلك الكياسة التي نجدها في خدور النساء، وداخل مساكن الفقراء. بسببه، اعتاد فلاحونا على تنسيق الزهور، كما اعتاد أكثر عمّالنا خشونة على أداء التحية للصخور ومياه الأنهار. وقد نصف في تعابيرنا الدارجة إنساناً ما بأنه “خلو من الشاي”، حين يكون منيعاً إزاء الميول “الجدّ-هزلية” التي يشهدها مسرح الدراما الشخصية. أما ذلك الجامح في شغفه بالجمال الذي، يتناسى مآسي الحياة الدنيا، ويعيش حياة مستهترة في ربيع المشاعر الحرّة، فإننا نصفه بالقول إنه “مفعمٌ بالشاي”.
وقد يعجب غير اليابانيين من كل هذه الجلبة التي نثيرها نحن حول أمر بسيط كالشاي. وقد يقول قائل منهم إننا نثير عاصفة في كوب من الشاي! لكن حين نأخذ في الاعتبار مدى ضآلة كوب المسرّات البشرية، وكيف أنه سرعان ما يطفح بالدموع، أو يجفّ إلى مجرّد الحثالة، في ظمئنا الذي لا يرتوي للوصول إلى المطلق (اللامتناهي)، فعلينا ألا نقسو على أنفسنا كوننا نحمّل كوب الشاي كل هذه المعاني. لقد ارتكب الجنس البشريّ ما هو أسوأ من ذلك. ففي عبادتنا لباخوس ، قدّمنا الأضاحي البشرية بوفرة، كما أننا مجّدنا الصورة الدموية لإله الحرب مارس. فلمَ لا نحيط بهالة من التقديس، والحال هذه، ملكة الكاميليا؟ لمَ لا نجد المتعة في ذلك النهر الوجداني المتدفّق من مذبحها؟ قد نلامس في السائل الكهرماني داخل كوب من البورسلان العاجي ذلك الصمت العذب الذي يغلّف كونفوشيوس ، وتلك الحدّة الصرفة لدى لاوتسي ، وذلك الشذا الروحاني المحيط بساكياموني نفسه..
إن أولئك الذين لا يحسّون بضآلة الأشياء العظيمة في ذواتهم، ميّالون إلى إهمال العظمة الكامنة في الأشياء الصغيرة لدى الآخرين. إن الغربيّ العادي، الغارق في الاكتفاء الذاتي، لا يسعه أن يرى في حفل الشاي إلا دليلاً آخر على الغرائب الكثيرة التي تشكّل سحر الشرق وطفوليّته. وكان يعتبر اليابان بلداً بربرياً، في الوقت الذي انغمست فيه في فنون السلام الرقيقة: وبدأ يعتبرها متحضّرة حين بدأت ترتكب المجازر بالجملة في ميادين القتال في إقليم منشوريا. وقد تعرّض “قانون الساموراي”، فنّ الموت ذاك الذي يدفع جنودنا إلى التضحية بأرواحهم بكلّ سرور، إلى النقد الكثير أخيراً. لكن بالكاد يبدي هذا الغرب أيّ اهتمام بـ “الشايية” الذي يجسّد الكثير من فن الحياة عندنا. إنه لمن الأجدى لنا أن يعتبرنا الآخرون بربريين، إذا كان انتسابنا إلى الحضارة سيقوم على المجد الرهيب المتأتي من الحروب. وإننا لنكون أكثر سروراً إذا ما انتظرنا ذلك الوقت الذي تحترم فيه بالكامل فنوننا وقيم عيشنا.
متى سيبدأ الغرب بفهم، أو بمحاولة فهم، الشرق؟ نحن الآسيويين غالباً ما تروّعنا تلك الشبكة الغريبة من الحقائق والأوهام التي نسجت حولنا. فنُصوَّر على أننا نقتات على زهر اللوتس، إن لم يكن على الفئران والصراصير. وغالباً ما نوصم إما بالتعصّب العاجز، وإما بالاستغراق الدنيء في الملذات. فتعتبر الروحانيات الهندية مثلاً جهلاً، والرصانة الصينية حماقة، والوطنية اليابانية نتيجة للتسليم بالقضاء والقدر. وقد ذهب بعضهم إلى حدّ زعم أننا أقلّ إحساساً بالألم والجراح بفضل صلابة جهازنا العصبي!
لمَ لا تسلّون أنفسكم على حسابنا؟ تردّ آسيا الإطراء بإطراء مماثل. ستكون هناك مادة أكبر للتندّر إذا ما أطلعناكم على كل ما نتخيّله ونكتبه عنكم. ستجدون الفتنة كلها، وكل العجب، وستجدون أيضاً الازدراء الصامت لكلّ ما هو جديد وغير مفسّر. لقد أتخمتم بالفضائل الأكثر نقاء من أن نحسدكم عليها، ولقد اتهمتم بالجرائم الأشدّ فظاعة من أن تدان. لقد أخبرنا كتّابنا في الماضي – أولئك الحكماء وذوو العلم منا – بأنّ لديكم ذيولاً كثيفة الشعر تخبئونها داخل ثيابكم، وأنكم غالباً ما تتناولون لحوم الأطفال الرّضع! لا، لدينا حجّة أسوأ ضدّكم: لقد اعتدنا أن نعتبركم الشعوب الأكثر افتقاراً إلى الحسّ العمليّ على كوكب الأرض، ذلك أنكم تبشّرونَ بما لا تمارسونه قطّ.
إن مثل هذه التصوّرات الخاطئة تتبدّد سريعاً بين ظهرانينا. لقد فرضت التجارة اللغات الأوروبية على الكثير من موانئ الشرق. والشباب الآسيويون يتدفّقون إلى الكليات الأوروبية لكي يتسلّحوا بالعلوم الحديثة. إن بصيرتنا لا تنفذ إلى أعماق ثقافتكم، لكننا على الأقل مستعدّون للتعلّم. وقد تبنّى كثير من مواطنيّ العديد من عاداتكم ومن آداب سلوككم، متوهّمين أن ارتداء ياقاتكم الرسمية واعتمار قبعاتكم الحريرية الطويلة من شأنه إكسابهم حضارتكم. بائسة ومحزنة مثل هذه المظاهر التي تعكسُ مدى استعدادنا للاقتراب من الغرب جاثمين على ركبنا. ومما يدعو إلى الأسف أن الغرب يتّخذ موقفاً غير محبّذ لفهم الشرق. فالإرساليات المسيحية تأتي لكي تنشر أفكارها لا لتتلقّى أفكار الآخرين. وغالباً ما تستمدّون معلوماتكم عنا من الترجمات القليلة المتاحة من آدابنا الضخمة، إن لم يكن من النوادر التي لا يمكن الاعتماد عليها التي يرويها المسافرون العابرون. إنه لمن النادر أن تساهم شهامة يراع لافكاديو هيرن أو يراع مؤلّفة “شبكة الحياة الهندية” في إضاءة الظلمة الشرقية بمشعل أحاسيسنا الخاصة.
لعلّي بمثل هذه الصراحة أظهر جهلاً بثقافة الشاي. ذلك أنه في صميم روح الكياسة التي تعلّمنا إياها ثقافة الشاي أن نقول ما يتوقّع الآخرون سماعه، لا أكثر. لكنني لن أكون واحداً من مريدي الشاي المهذّبين. فقد ارتُكب حتى الآن ما يكفي من الضرر جرّاء سوء التفاهم بين “العالم الجديد” و”العالم القديم” بحيث ليس من داع لأن يعتذر أحدنا عن حجم مساهمته في تعزيز فهم أفضل. كان يمكن أن تتجنّب بداية القرن العشرين مشهد الحرب الدموية لو أن روسيا تنازلت للتعرف على اليابان بصورة أوثق. أيّ عواقب وخيمة يجرّها على البشرية جمعاء ذلك الجهل المزدري بمشكلات الشرق! إن الإمبريالية الأوروبية التي لا تخجل من رفع عقيرتها عالياً بتلك الصرخة العبثية ضدّ ما تسميه التهديد الأصفر، أخفقت في إدراك أن آسيا أيضاً قد تتنبّه يوماً إلى تلك الفظاظة الكامنة في “الكارثة البيضاء”. قد تسخرون منا لأننا نحتسي “الكثير” من الشاي، لكن ألا يدفعنا ذلك إلى الشكّ بأن أنماطكم الفكرية “خلو من الشاي”؟
فلنوقف القارّات عن رشق بعضها بعضاً بضروب السخرية، ولنكن أكثر حزناً، إن لم نكن أكثر حكمة، جرّاء المكسب المتبادل لنصف الكرة الأرضية. لقد تطوّر كلّ من نصفي الكوكب في خطّين مختلفين، لكن ليس من سبب يمنعنا من أن نكمّل بعضنا بعضاً. لقد كسبتم التوسّع وخسرتم راحة البال؛ أما نحن فأنشأنا تناغماً ضعيفاً تجاه العدوانية. أتصدّقون ذلك؟ إن الشرق أفضل حالاً في بعض النواحي من الغرب!
من الغريب بما فيه الكفاية أن الإنسانية قد التقت حتى الآن على كوب شاي. فهو الطقس الآسيوي الوحيد الذي يحظى بالاحترام الدولي. لقد استهزأ الرجل الأبيض من ديانتنا وقيمنا الأخلاقية، لكنه تقبّل شرابنا الداكن هذا دونما تردّد. إن احتساء الشاي عند العصريّة بات مناسبة مهمة في المجتمعات الغربية. ففي “القرقعة” اللطيفة للصواني وصحون الأكواب، والحفيف الناعم للضيافة الأنثوية، وفي التعاليم الشفاهية السائدة عن الكريما والسكّر، نعرف أن “عبادة الشاي” أصبحت رائجة بما لا يدع مجالاً للشك. إن ذلك الحسّ الفلسفي الكامن في تسليم الضيف إلى المصير الغامض الذي ينتظره في حركة غليان الشاي، يظهر أن الروح الشرقية حازت التفوّق في هذه الحركة البسيطة.
يقال إن أولى الروايات المتعلّقة بالشاي في الكتابات الأوروبية تنسب إلى أحد الرحّالة العرب، وتفيد بأنه بعد العام 879 م. كان مصدر الدخل الأساسي في إقليم “كانتون” هو الرسوم الجمركية المفروضة على الملح والشاي. ويسجّل ماركو بولو حادثة إعفاء وزير المال الصيني من مهامه في العام 1285 م بسبب الزيادة التعسفية في ضرائب الشاي. وفي حقبة الاكتشافات العظمى بدأت الشعوب الأوروبية تعرف أكثر عن الشرق الأقصى. ففي نهاية القرن السادس عشر جاء الهولنديون بالأخبار التي تفيد بأن ثمة شراباً طيب المذاق يصنع في الشرق من أوراق شجرة ما. كما أن الرحّالة جيوفاني باتيستا راموسيو Giovanni Batista Ramusio (1559 م)، ول. ألمايدا L. Almeida (1576 م)، ومافينو Maffeno (1588)، وتاريرا Tareira (1610 م)، أكثروا أيضاً من ذكر الشاي. وفي هذه السنة الأخيرة، 1610 م، حملت سفن تابعة لـ “الشركة الهولندية لشرق الهند” أولى شحنات الشاي إلى أوروبا. وقد بات الشاي معروفاً في فرنسا في العام 1636م، ووصل إلى روسيا في 1638 م. أما إنجلترا فقد رحّبت به في العام 1650 م، ووصفته بأنه “ذلك الشراب الصيني الممتاز الذي يصدّق عليه جميع الأطباء، يسميه الصينيون “تشا” Tcha وتسميه الأمم الأخرى “تاي” Tay والمعروف باسم “تي” Tee (الشاي)”.
على غرار كلّ ما هو جميل في العالم، واجه الصيت الحسن للشاي بعض معارضة. فثمة هراطقة من أمثال هنري سافيل (1678) الذي شجب شربه بوصفه عادة قذرة، وقال جوناس هانواي (في مقالة له عن الشاي، 1756) إنه يبدو أن الرجال يفقدون لياقتهم ومكانتهم، وتفقد النساء جمالهن بسبب شربهم الشاي. وقد حالت كلفته الباهظة في البداية (نحو خمسة عشر أو ستة عشر شلينغ ) دون انتشاره على نحو شعبي واسع، وجعلته “رمزاً يدلّ على الضيافة الرفيعة، وهدية تهدى إلى الأميرات والنبلاء”. بيد أنه رغم هذه المعوّقات فقد انتشر شرب الشاي بسرعة مذهلة. وتحوّلت بيوت القهوة في لندن، في النصف الأول من القرن الثامن عشر، إلى بيوت شاي، وأصبح الشاي ملاذ مفكّرين من أمثال أديسون وستيل ، اللذين كانا يستمتعان بشرب “طبق من الشاي”. وسرعان ما تحوّل هذا الشراب إلى ضرورة حياتية، وإلى منتج تجاري خاضع للضرائب. وقد استسلمت أمريكا المستعمرة للاضطهاد حتى نفد الصبر الإنساني قبل فرض الضرائب الكبيرة على الشاي. ويعود تاريخ الاستقلال الأمريكي إلى رمي حاويات الشاي في ميناء بوسطن .
ثمة سحر خفيّ في مذاق الشاي يجعله لا يقاوَم وقادراً على إسباغ إحساس بالمثالية. ولم يتوانَ الفكاهيون الغربيون عن مزج عطر أفكارهم بعبق الشاي. فالشاي ينأى بنفسه عن غطرسة النبيذ، وعن غرور القهوة، وعن البراءة المتكلّفة في نبتة الكاكاو. وفي العام 1711 م روّجت صحيفة “سبكتاتور” لنفسها بالقول: “إنني أنصح كل العوائل التي تعيش حياة منظّمة، فتوفّر ساعة صباحية لشرب الشاي وتناول الخبز والزبدة، بأن يطلبوا، لمنفعتهم، هذه الصحيفة، وأن تكون جزءاً من عربة الشاي”. أما صموئيل جونسون فيصوّر نفسه كشخص “لا يتورّع عن شرب الكثير من الشاي، ظلّ طوال عشرين عاماً يمزج وجباته بهذا النقيع الناتج عن هذه النبتة المذهلة، فهو يستعين بالشاي لتمضية المساء ثم منتصف الليل، وبه يستقبل الصباح”.
أما تشارلز لامب ، وهو ممن يعلنون صراحة ولاءهم للشاي، فتلخّص ملحوظته التالية “الشايية” حيث يقول إن أعظم المتع هي القيام بعمل طيّب خلسة، وأن يكشف أمره صدفة. ذلك أن الشاي هو فن إخفاء الجمال بغرض اكتشافه، فن الإيحاء بأنك لا تجرؤ على الإفشاء به. إنه السرّ النبيل الكامن في السخرية من الذات، بهدوء لا يخلو من عمق، وهو بالتالي يجسّد الفكاهة عينها – ابتسامة الفلسفة. كل الفكاهيين الأصليين يمكن أن يسمّوا وفقاً لهذا الاعتبار بـ “فلاسفة الشاي”، ثاكراي ، على سبيل المثال، وبكلّ تأكيد شكسبير. وقد ساهم شعراء الانحطاط (متى لم يكن هناك انحطاط؟)، من خلال احتجاجهم على شيوع المادية، قد مهّدوا الطريق أيضاً، إلى حدّ ما، لـ “الشايية”. ربما لعب تأملنا الرصين لـ “النقصان” في عصرنا هذا دوراً في إمكانية التقاء الغرب والشرق في نوع من المؤاساة المتبادلة.
وقد جاء في مرويات التاويين أنه عند البداية العظيمة لما يسمّونه “اللابداية” No-Beginning تواجهت الروح والمادة في معركة مميتة. وفي النهاية انتصر الإمبراطور الأصفر، شمس السماء، على شو يونغ Shuhyung، شيطان الظلمة والأرض. وفي خضمّ آلام النّزع ضرب الجبّار رأسه بقنطرة السماء فشظّت قبّة اليشم الزرقاء إلى شظايا. فقدت النجوم موطنها، وهام القمر على غير هدى في الليل البري. وإذ اعتراه اليأس سعى الإمبراطور الأصفر لإصلاح السماء. ولم يضطر إلى البحث عبثاً. فمن بحر الشرق برزت الملكة نيوكا Niuka المقدّسة، ذات القرون والذيل الشبيه بذيل التنين، متوهّجة في درعها النارية. وقد مزجت هذه الملكة ألوان قوس قزح الخمسة في مرجلها السحري وأعادت تشييد سماء الصين. لكن يروى أن نيوكا نسيت أن تملأ فجوتين صغيرتين في قبة السماء الزرقاء، فنشأت ثنائية الحب – روحان تتدحرجان في الفضاء ولا تجدان مستقراً البتة حتى تنضما إلى بعضهما لكي تكملا الكون. وهكذا، يتوجّب على كل إنسان بناء سماء الأمل والسلام مرة بعد مرة.
إن سماء البشرية المعاصرة قد تشظّت بالفعل في ذلك الصراع السايكلوبي على الثروة والسلطة. إن العالم يتلمّس طريقه في ظلمة الأنانية والابتذال. إن المعرفة تشرى لنوايا سيئة، والخير يمارس كرمى للمنفعة. إن الشرق والغرب، أشبه بتنينين في بحر هائج، يكابدان عبثاً للحصول على جوهرة الحياة. نحتاج إلى نيوكا جديدة تصلح الخراب العظيم؛ ننتظر المثال الفلسفي العظيم. في الأثناء دعونا نرتشف بعض الشاي. إن ضوء بعد الظهر يشعّ خلل القصب، والينابيع “تبقبق” بالمسرات، ويمكننا سماع أنين الصنوبرات في غلاية الشاي. لنحلم بالفناء، ولنمكث قليلاً في الحماقة الرائعة للأشياء.
الفصل الأول من “كتاب الشاي” ل”أوكاكورا كاكوزو”
ترجمة وتقديم الكاتب والشاعر سامر أبو هواش \
صادر عن مشروع “كلمة” للترجمة
خاص بموقع “الرأي” بالاتفاق مع “كلمة”




