الريـف والمدينـة فـي السـينما السوريـة
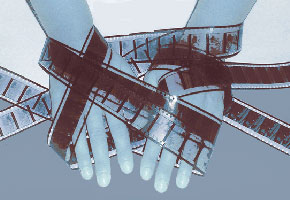
علي جازو
لنبدأ دون مقدمة بفيلم«نسيم الروح» للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد التي، أي الروح، غادرت ـ هكذا يبدو في الظاهر على الأقل ـ الريفَ وبساطته المزيَّفَة المغنّاة.
نسيم الروح؛ هذه التسمية المغمورة بأحاسيس الريف المشوقة، لكونه حسبما هو شائع، البدايةَ والخير والنقاء. كان شاعر المجر الشهير «يوجيف إيتلا» يرى أن «الأبدية ولدت في الريف»! فرناندو بيسوا رأى في الريف المكان الذي لا نكون فيه. هناك، هناك وحسب، توجد الأشجار الحقيقية والظلال الحقيقية. ومن قول كهذا تصير المدن بلا مديح يذكر. إثر فيلمين هما «رسائل شفهية، وليالي ابن آوى»، كانت القرية وكلام أهلها الهزيل موضوعهما؛ حققا نجاحاً «جماهيريا» لما حملاه من حسّ كوميدي مصطنع، اعتمد في جلّه على زعيق المبالغات اللفظية الرائجة ـ تتحمل الجماهير المخدرة تبعة قبولها وتكرارها السوقيّ ـ يقدّم عبد الحميد فيلم عشق «مثالي التكلّف» في مدينة غير جديرة بعشاقها وغير قادرة على تحمّل شطحات خيالهم العاطفي الساخن الساذج. تجدر الإشارة هنا إلى فيلم آخر هو «صعود المطر» الذي يعد بحق علامة بارزة وغير مألوفة على موهبة المخرج نفسه، إضافة إلى «نجوم النهار» لأسامة محمد و«أحلام المدينة» لمحمد ملص. الأفلام الثلاثة الأخيرة، دون إغفال فيلم «الكومبارس» للمخرج نبيل المالح، يمكن اعتبارها الأفضل والأكثر جودة بين مجمل إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا التابعة إدارياً لوزارة الثقافة واقتصادياً لذاتها المبنية على فقر مقصود تلاه لعقود ضعفٌ آخر جرت صناعته على هدي الإرشاد القومي. لكنها الأفضل ـ إلى حينٍ قد لا يعقبه حينٌ أحسن ـ لما قدمته من رهافة وجدة في الأسلوب وعمق دقيق في المشهد البصري تعينه معالجة متأنية للسيناريو والحوار، على اختلاف طرق ومذاهب المخرجين المذكورين الذين تجمعهم هنا خصوصية هذه الأعمال. كان فيلم أسامة محمد مزيجاً من الريف والمدينة معاً، ومستقلاً عنهما في الوقت ذاته. ثمة مسافةٌ حيّةٌ هي مرآة عين المخرج وخلاصة رؤاه في العلاقات الإنسانية المحبطة البائسة الناتجة عن عالمي الريف والمدينة (العاصمة دمشق حصراً) الموبوءين بالصورة نفسها «للمطرب فؤاد غازي رمزاً متنقلاً» من عرس ريف محجور النموّ إلى ساحات مدينة تضيئها حفلات حجّرها الأسى الأخرس؛ الصورة التي التهمت وتلتهم، إلى الآن بشراهة الفساد الخالد، كلَّ ما يقع خارجها ولا يماثلها. إنها تحجبه إذ تشرده، تخيفه لتخفيه، تعرضه خافتاً كصرخة معلقة فتبتلعه صمتاً معتماً في ضبابها القذر الكثيف.
«أحلام المدينة» سردٌ حكائي متقن وآسر،عدا خاتمة الفيلم المقحمة دونما ضرورة، سوى حاجة غير مبررة لتأريخ نهاية مرحلة قُلّصَتْ بها إلى حدث سياسي محض (يكرّر ملص التهاون نفسه والمزلق نفسه بحدّ أشدّ ضعفاً في «الليل»،و«باب المقام» الأكثر تهافتاً وقلّة تحكّمٍ)، لكنه يظهر نقياً وصافياً، متأملاً كما يقتضي التأمل الرقيق الدقيق، بهدوءٍ جليّ وبطءٍ خفيّ، كاشفاً فترة مسلوبة التدوين المحايد من حياة سوريا القريبة الممحوّة.عينه المولعة، في شاعرية ظليلة، بالتفاصيل والهوامش وانتقاله الحذر السلس من مشهد لآخر يسدل بعداً أرحب في تناول الصور وشحنها، عذوبة غضة، بأكثر من إحالة وتأويل. إنه فيلم الهروب كرهاً من الريف إلى المدينة، حيث السقوط مجدداً في شرك القمع الاجتماعي، وبازار الفوضى السياسية، ناهيك عن السلطة الذكورية القاسية الرعناء. هروب يكرّس الفشل ويجدد الإحباط مختوماً بعزلة في هيئة نشيد لا يمثل غير صوته المتعالي! لا المدينة ـ الأمل المرجوّ ـ بأضوائها وأعلامها، تنقذ أو تحضن، ولا الريف بنأيه الساكن يُلجَأ فيحمي. كلاهما عراءُ «السوريّ» من غده، كلاهما تيهٌ وسقمٌ.
«صعود المطر» الزاخر بحلم طويل متواتر ومتشعب، شديد الغرابة والتكثيف، غير المعهود، يحيطك منذ بدايته بعالم غير جدير إلا بقلبه رأساً على عقبٍ. لا يمكننا، تبعاً لذلك، تصنيفه في مدينة أو ريف. هو سجّلُّ الإنسان شقياً ينوء بإنسانيته فحسب، حاملاً كالمطر الصاعد توقه إلى جمال خاص وفريد فيه الرقص آية بهاء الجسد المعشوق ورغبة تحقق حبّ الحياة، لكن الجميل كالمحبّ لا يملك «قوت ولا قوة الشارع» ليدوم ويزهر. وها هي حياته بترٌ لحياته، وما عليه إلا أن يكتب ويُكتَبَ في مكان آخر، بعد أن أصبح المعيش المرذول حتف الخيال. عليه أن يستمر ويزدهر في قبره المتخيّل والحقيقي معاً. حلمٌ يدلّ على صوابٍ لا يكون سوى خطلٍ في واقعٍ يؤيد الغباء! الدهشة كامنة في ما لا يُرى، وسخاء الروح المقيدة يتواضع ناعماً في رهافة جسدٍ يئنّ آن يرقص. حلمٌ يتمدد في حلمٍ هو الدوام على كتابة خياله والتمسك إلى ما لا نهايةٍ بضوء الحاجة إلى إدراكه وإنْ كان ذلك في عالم الكتابة فحسب!
في «نسيم الروح» لا يكف الحلم، مصنوعاً كخطاب مضاد لعادات لا ترد، كطاقة إيحاء ذهنيّ عن إظهار تثلّم قراءة عبد اللطيف عبد الحميد ومقترحاته الخيالية. الحلم ـ إيماءً وخطابةً ـ يسقط أينما كان ليلحم فجوات نسيج الفيلم المهلهل في أكثر من مكان، مقدماً في الجوهر خلاصة تبشيرية لا لغة سينمائية. فيلم أمل واقع آخر يتمّ إرجاؤه وخنقه كلّ يوم. خفاءً ينتقل الواعظ الديني لابساً وجه الحالم الاجتماعي، ليشكلا في تضافر نافر وفجّ عقمَ العامل الاجتماعي السخيف والمستند في لاوعيه إلى شمولية وتهافت المنعرجات الدينية. بغير طريقة يتداخلان ويمتزجان. ظاهراً لا يبدو هذا الأمر جلياً، لكنه في لبه رسالة الفيلم وفحواه: على الحالم أن يموت، والعاشق المقتول شهيد ممدوح. ثمة نمذجة هنا. يستجلب الحلم قناعاً أو حائط دفعٍ لواقع يعاديه ويلجم لسانه غير المقبول، لكنه، أي الحلم، يقدّم أبيض ملائكياً لا تشوبه قسوة الواقع ولا قذارة الحاضر المهادن كخرابٍ عميم. في الريف والمدينة قطيع هادر لا يرحم والزمن ليس زمن ملائكة أبداً! هكذا بشكل غير متوقع تغدو طاقة الحلم المشهدية والنفسية غريبة وعاجزة، في تصنّعٍ واضحٍ،عن يوميات الحياة الفعلية؛ تتعالى عن حقيقتها المهانة في الوقت الذي تظهر فيه ملتصقة بها لتشبُّعها وامتلائها بمفردات الواقع المشلول ومبرزاته التي جرى اقتناؤها خدمة لرؤية المخرج الضحلة غير المنغرزة في روح الحطام اليوميّ. لقد مدّد عبد الحميد مشاهد الواقعي وفرّعها، رغم عدم تماثلها مع الواقع نفسه، كثرثرة زائدة بناءً على لحظات أحلام خرساء من فرط كلامها المعاد الركيك. لقد تمّ تحويل ما يفترض أنه الواقع إلى أثر مختلق لتفاعل الشخوص وأحلامهم، لكن بهذه الطريقة جرى تشويه الاثنين، الواقع والحلم.
كانا يستحقان المكوث منفصلين ومستقلين كرؤى في قيلولة تشبه عبارة إليوت الفذة: «ليس لك شباب ولا شيخوخة بل كما لو كنت في قيلولة وحلمت بكليهما». إن القول المستهلك وغير الدقيق: إن الواقع مرآة المجتمع وإن الأحلام ما هي إلا خيالات رومانسيين. إن مثل هذه التعاميم السخيفة هي التي أفسدت وهج الصور المفارقة وحجمتها داخل مسار واحد جامد هو الوعظ والتلقين؛ أي حبس لسان الواقع وتأويل الأحلام وفق منطق الحاجة الجماهيرية، التي هي كتلٌ معاقة وليست حيوات أفراد متمايزين، والتدجين الاجتماعي الرسمي، غير مختلفين عن وصايا وقرارات «المنظمات الشعبية» التي لا صفة لها سوى الترهل والعجز. الحاجة، بإخلال أصلها، أمست نقيضها، وتوحيد الصوت أثمر القيء! ألا يجدر بالمخرج، أي مخرج، أن ينسى ذاته وهو يحلم متأملاً شخوصه الحالمين؟ أن ينأى ويشذّ فلا يعرف الحلم من غيره؟ أوَليست السينما هي هذا الالتباس الدقيق والنضر كوساوس الفيلسوف «سيوران»: (مخالطة الآخرين أفسدت عليّ نضارة وساوسي).
قد يكون الهجين، محمياً بالتفتّح العميق، السمةَ الأكثر نقاءً للأصل. وقد تكون «الخلاسية» و«الخنوثة» باب خلاص من سجن (الواحد الخالد). غير أن الفيلم الحلم لا يكف عن أسرنا وجذبنا إلى عالمه الأثيري بهدوء وملاحة الساهي، وكأن تفاصيله هي بنت تفاصيل الواقع المرّ ـ المحكَم غير القابل للكسر والتبديل. لكن الأحلام ليست تعويضاً عن خسارة أو تحويلاً للألم فحسب؛ وهذه علامة أخرى على اهتراء الواقع الراضي بيقين مسطح عن مثل تفسير كهذا. ليس «الحلم» تنفيساً عن الرغبة المكبوتة أو إحياء للأمنية المجهضة. إنه الإمكان المتألق لما لم يكن بعد، وما إرجاؤه العفيف سوى وساعته النامية. إنه بذرة محتملة لواقع لا يحتمل غيره، وما هذيانه سوى قناع حريته، وأي شأن أنبل وأجلّ وأمثل من الحرية!؟ إن فتور المخرج ـ هو كاتب السيناريو والحوار ـ في نسج الكلام حواراً معتاداً، داخل الحلم وخارجه، أوهن شرود الحالم بيقظة المتكلم، وأسقط ألفة الكلام في عمومية الشكل ولفظه، فشلَّهما عن التوقد والامتداد. تماثل التكلّم، بسرد الحلم مسلوخاً ومعادياً بالواقع، يفضي إلى تماثل أعمق وأخفى وأخطر: إنه يكرّس جزاء الفعل بعدم الفعل، فيجعله بقول «أدونيس» عملاً يشبه الكسل أو كسلاً يشبه العمل.
من زاوية أخرى يتحرك الحلم، في مسعاه الإنساني الرحب، تساؤلاً وبحثاً، سفراً للعزاء النبيل، شَكّاً يفضح ويجرح، مسباراً ومختبراً لفحص مدى أهلية الواقع للتبدّل المرجو، وإدراك حاجة الفطرة البريئة إلى التقلّب والتجاوز بانسجامٍ مدهش، لكنه لدى عبد الحميد، وفي نسيم الروح تحديداً، وكما هي العادة لدينا غالباً، يتعثر آن يفصح، وينحصر في نفسه الضيقة إذ يحسب القفز فوقها قد أنجز خطوته الحاسمة. إنها العادة ـ هَدْرُ العقل وهَجْرُه مثلما هو الأمر بالنسبة للغرائز كذلك، إذعانُ الحياة للواقع المذلّ ـ أنجبت آلتها العملاقة الكسولة في تلمّس الحواس والأفكار الوجلة؛ فقوة الاعتياد الصلبة باستبدادها الفائق على الحبس والإعاقة ـ حبس الحاضر المريض، والمعيش المتهالك، بإرجاعهما قهراً إلى ماضيهما المرعب، تحجّرُ توهّجَ الحلم وتروّض حيوان خياله، فتسوّره بحدود السهل البائس والمتعارف الكريه والمتوقّع البليد.
هكذا ينسخ الكسلُ ـ جوهرُ الخطأ ـ كلَّ بادرة روحية أو فكرية خاصة. واللغة تجفّفُ اسمَها وتلوي مسارها، ملتهمةً تأويلَها قبل عرض صورها. تنظفّه وتعقّمه، كأنها تخرّبه وتعطبه، أي تجعل التأويل، الذي هو فرادة الفكر الحرّ الخالق، خرساً مطبقاً، أثراً لتزيين الوقت المنهوب حتى يثوب الركيك المتسلّطُ، واقعاً بلا شارة لطفٍ، إلى (رشده الناضج الآمن) فيتمِّمَ ببشاعة القناعة والصبر التالفين خرابَه المتسلّط وعقمَه المصان! المَشاهِدُ على ألفتها الكسيحة وغرابتها أحياناً، تتوازى، تتأرجح فتتوازن لوهلة يبدو معها المخرج ذا قدرة في مزج الأحلام بنقيضها عبر كسر جمود الحياة اليومية بطوف الأحلام وسحرها الأخاذ، لكنّ هذا التوازن السطحيّ، القائم على التقابل لا التداخل، لا يصمد على مدار الفيلم، وهو على نقيض ما يظهر، يخلّ بصداقة الحلم كذروة نشاط حسيّ وذهني، تالياً إضعاف جدارة الفيلم كشاهد حرّ ونزيه وفرديّ عما يحدث ولا يحدث. كان على الأحلام أن تحمل خللاً ما، تشوشاً وهذياً، فتشير، دون مواربة، إلى عطبٍ شرهٍ، قهرٍ مقيمٍ، وغضبٍ صدئٍ كمآل وحال ومنال الحياة الراهنة. لكنها تتجلى نظيفة دون كدر، لامعة لم ينلها خدش. لا نرى أبداً بقع الواقع القذرة وغير المحتملة. طيران الروح ورفرفاتها، حسب عبد الحميد، مثقلة ببرد التوهم وحياد المتفرج على نفسه غير ممسوسة بذعرها، فلا ينفذ التنائي الشحيح إلى صلب ومخاوف الواقعي المهمل. هكذا، بعون العين السليمة الخاملة، يتصادق الفقر والعهر والعجز والرمز، ويهبط الفصيح البعيد في عتمة القريب العامي. لكن القريب والمعروف يستهلكان عقلك وعينك، فلا «ترى» إذ تشهد، ولا تعود تحس آن تحسب، عن تشارك لفظي مقنّع، أنك المشاهد المنفعل. حضور الواقع بهذه الصيغة الركيكة هو غيابٌ خَدِرٌ للأنا المسحوقة بالواقع.
«الروح» الحرة اللطيفة،وادّعاءُ نسيمها المنعش، مقيدان ومحجوبان بترس الواقعية السافرة؛ فحلمُهُما البريء من نسيج مفترسهما الثرثار بعد تغلغله في صمت غدا بلادةَ التكلم وسلواه! هذه خسارة مزدوجة ومضاعفة، فالعادي المشترك، على بهائه المتواضع، من قسوة استهلاكه وعفونة اجتراره الإعلامي، غدا بلا صوت، وصورتُه علامة مَحْوِهِ. لسانُه عضلة بكماء بفعل التجميد الطويل لنموه الطبيعي ومنع حواسه عن النطق والتحرر.
الواقع جسدٌ متآكل، كيان معاق. واليأس الجديد تحوّلُ الحلم إلى واقع لن يكف، كعادته، عن التهام كل نأمة غريبة أو إشارة غير متفق عليها. شيئاً فشيئاً يخسر الحلم قوةَ نفوذه وسلطانه، تخفت جاذبيته، ويبهت إشراقه. تسلبه شموليةُ الفكر ضياءَه النحيل، فيعتم ويطوف غريقَ تأملاتٍ سطحية، جثة بلا ملامح، عذاباً بلا شكل!
وسرعان ما يذيب التكرارُ ألمَ الساعات دون إزالة، وتكنسُ الجثثَ يدُ الواقع غباراً نَسْلَ غبارٍ! لم يترك الحلم في هبوبه أي جرح، لكأن نسيمه ابنُ العافيةِ لا المرض، الكمالِ لا الحاجة، النعيمِ لا العوز، الرضى البائس لا الحبّ العنيف. لكأن الجرحَ ليس صورة كل مرضٍ وخوفٍ ورغبةٍ. الزهرة السامة ـ سمة الذل الإنساني ـ لم تتفتح عن أي دهشة، فسمُّ وضِعَةُ ما يحدث ويُرى لا تدركهما عين المخرج، وخيالُه من جذْبِ الرضا المجدب لا نفور الرفض الملتهب. لقد حلم عبد اللطيف عبد الحميد بعيون مفتوحة و«عاقلة». ربما كان عليه أن يحلم «بعيون مغلقة باتساع». لدى أوكتافيو باث إشارة لافتة تغني عن كل إسهاب: «يتطلع الإنسان المعاصر إلى التفكير وهو يقظ ولكن هذا التفكير اليقظ قد قادنا إلى ممرات كابوس متعرج حيث تضاعف مرايا المنطق من غرف التعذيب، وعند الخروج قد نكتشف أننا كنا نحلم وعيوننا مفتوحة، وأن أحلام العقل بشعة. ربما حينئذ نبدأ في العودة مرة أخرى إلى أن نحلم وعيوننا مغلقة». مرئيات «نسيم الروح» كليلة وناقصة، الواقع محبوس عن صنيع الواقع، والصور باهتة كوجه معلول بلا الوجه الداكن فوق كل مشهد. هكذا تتقصّفُ الحركاتُ والحوارات إلى خلاصات غير بريئة ولا دقيقة عن ركام الحياة الفعلية.
تزييف
قسوة حياة المدن ومعها الأرياف، في سوريا، لا تظهر أبداً في أفلامها؛ بل يجري تحويلها، بدهاء أو غيره، إلى تقشّرٍ ظاهرٍ دون إيلام، تلوكه عينُ المشاهد على أنه من مظاهر العيش الفطرية وعاديات السلوك المحلي. الريف، خاصة، على شقائه وإهماله المديدين، في الأفلام السورية، يقنّع دون إقناع، في استغباء وبراءة متوهمتين، في سخاء وكرم مدعى بهما؛ سخاءٍ لا يعضّ يدَ القتل العبثي، وكرمٍ يحرس البلادة والمداهنة والرياء. ريفٌ مزيّفٌ كالمدن الوهمية الهشة، تقودها آلات التصوير إلى الحواضر ـ لم تتمدن بعد ـ لتؤنس رعبها وجشعها،وتهدّئ، عن نفاق طاغٍ، من قسوة صقيعها المجتمعي! الريف. إنه الجذر والأصل. وعلى الأصلي والمتقدم أن يعظ ويرشد. أيتها المدن، يا رماد الأبنية الجديدة القديمة، تلقّي الدرسَ والعبرة من أهل الريف. إنهم عرق الأرض وطيبها. هم أهلوك المخلصون، فأصغِ إلى وصاياهم وحكمهم كما يتقبل المؤمنون البسطاء آراء خطيب مفوه، فالبلاغة تكفي، والصراخ دليل الحزم، والحزم صفة المتمسك بالأصل النقي الخالص!
عقلية الريف هذه، جرى تحويلها مؤخرا إلى اقتصاد السوق الاجتماعي تخففاً من أورام وأوهام وسقام التحول الاشتراكي العتيد، بإضافة كذبة فارهة إلى كذبة أعتق غلواً ومرارة! بؤس الريف، حتى العظم، غير المعلن والمحجوب عنوةً، هي المسيطرة على الفكرة السينمائية السورية، أما تنوعه الإثني والعرقي والثقافي، لغاته ولهجاته، قلاقله ومخاوفه اليومية، إحباطه وتلقيمه اليأس الشامل، فيجب أن لا تظهر مطلقاً. ثمة فلترة وتمييع، ثمة وهم جاهز وتزييف طويل العهد، مع حلول مضحكة مبكية ما تزال تتحكم وتقود المشاهد من ضيق إلى ضيق، متناسية العمق الإنساني الكثيف والمتنوع الصارخ في كون السوري بأكثر من أصل وأوسع من قوام واحد وحيد!
لم يغادر عبد اللطيف عبد الحميد بيته الريفي بعد، سرعان ما عاد إليه بفيلمي «قمران وزيتونة» و«ما يطلبه المستمعون». إنه على العتبة السكون، العتبة الحرف، العتبة الضجر والقيد، وفي هذه الإقامة المتكررة تأرجحه وتخبطه في لغتين شأنين، ريف ومدينة، مزيجهما الصوت نفسه والإحالة نفسها: إبقَ حيث أنت؛ «الألمُ حجّرَ العتبة». لكنه يظل ناشراً «الوصايا» مجتراً في كوميديا قوامها اللفظ الهادر والتبجح الهاذي والرعونة الهاذرة، حاصراً عالم الريف بفئة بعينها، ومثل هذه «الكوميديا» التي يؤكد عبد اللطيف عبد الحميد ثقته بها واطمئنانه لها، لا يرفضها سوق العامة، ولا لجان القراءة في المؤسسة العامة للسينما، ولا غرف الخاصة المحكمة والراضية عن مثل هذه النماذج من الأفلام. (نشير هنا إلى فيلم «صندوق الدنيا» ذي السمة الخاصة لأسامة محمد الذي أنجزه بعد توقف دام 14 سنة، كما أن مشروع محمد ملص «سينما الدنيا» أهمل بعد ما يشبه الرفض، في وقت تصرف فيه وزارة الثقافة ومؤسسة السينما أموالاً طائلة على مهرجانات دمشق السينمائي، متناسية أنها تعيق أو تهمل مشاريع مخرجيها وأن مدناً كالرقة ودير الزور والقامشلي والحسكة وغيرها بلا أية صالة عرض سينمائية…).
كذلك فإن «جماهيرية» و«رواج» هذا النمط من الأفلام ليست مقياساً نزيهاً ولا دقيقاً على جودتها الفنية والأسلوبية. سيُرَدّ على هذا التقييم، ربما، بأن عبد الحميد حصّاد جوائز ونجم مهرجانات دولية (الوصف المقيم الدائم للأفلام السورية أنها أفلام جوائز ومهرجانات، حتى يكاد السوري يجهل أفلامه، فالتلفزيون السوري مثلا، لا يفكر بعرض استعادي لأفلام المؤسسة ولا المراكز الثقافية الحكومية….الخ).
الجوائر
هل الجوائز، على كثرتها المقلة في قيمتها، ومقاييسها المرسلة، معيار دقيق يمكن الركون إليه لتمييز فيلم عن سواه؟! إنها، أي الجوائز، دعاية الفيلم وإسكاته معاً، فهي نتاج آليات ومهملات لجان التحكيم التي لا يمكن الوثوق بها دائماً، والتي تلجأ كما هو معروف في نصاب منح الجوائز إلى أمور وظروف لا تعتمد شأن الفن من شأن المكافأة. لا شيء يعزز السينما ويدهش جمهورها سوى سينمائية الفيلم وعمقه الفكري والجمالي، إنها البهاء المنفعل بل برؤية بوشكين: «الخيال الذي يجعلنا نذرف الدموع!»، هذه أصول وقواعد لا ينبغي نسيانها في معرض قياس جودة الأفلام من عدمها. أما الجماهيرية فهي بذاتها عطالة الفيلم ويأسه المعاكس. المسلسلات على كثرتها الخانقة جماهيرية، كما كليبات الأغاني الاستعراضية وحوائج الاستهلاك اليومي. الجمهور، بأسف وأسى، الكلّ المحجوب حتى عن نفسه، يمدح ويثني، يضحك ويصفق ويخرج راضياً كأنه لم يدخل ليكتشف شيئاً جديداً، إنها لحظة حاجبة ومؤقتة سرعان ما تنسى وتندثر، لحظة توافق الحس المجمد مع الصورة المجمدة (هل نشعر بالرضا والبهجة بعيد فيلم لبرغمان مثلاً! أو عباس كياروستامي؟) القمع الثقافي، تجهيلاً ومنهجاً، يهادن جلال الصورة وإغراءها، عبر سحبها من براءتها ولاانتمائها، في سرية ضحلة وادعاء لفظي كالبلاغة السياسية الميتة، إلى جحر الرقيب وظلامه المعيق السيّد لكل فردية وخصوصية. هكذا يتداخل السياسي الهزيل مع دعاية وترويج صورة يجري نسخها طبقاً لحاجات الإلهاء العامة التي تحل مع غيرها من حفلات ومواسم الثقافة المحنطة لإكمال الإحكام السلطوي الموحد وعزل صوت الفرد أو جعله جزءاً نافلاً، رقماً في عداد كتلة، من أصوات عامة لا يمثل أي منها الحسية الفردية ولا حاجة الصوت الحرّ إلى التكون والـتأثير. بمثل هذه المقاييس، فلنكتف إذاً بمسلسلاتنا «التاريخية» «الفانتازية»، لنكتف بمطربينا ومطرباتنا على سخونة ورداءة وسخف سوق العرض والطلب. لا أعلم، ولا أفهم، حقاً، وفق أي ميزان «سحري» صارم ومرن يمكن قياس الجودة والرقي؟! لكننا، بعقل الإنصاف والحذر نفسه، ينبغي ألا ننسى أن «الجمهور» الذي «يشارك» و«يزحم»، كطرف متلق أسير ومستسلم، في هذه السوق السوداء، السوق الوباء، قد أجبِرَ بطريقة أو بأخرى على التعود الإلزامي وقبول كل ما يقدّم إليه، لكونه الوحيد والمسموح والشائع، لا سيما أنه بدءاً من مدرسة التلميذ وانتهاء بجامعة الطالب، من ألف الزيف إلى ياء اليتم، لم ينل ما يستحقه أي «مواطن عادي» في حياة عادية من تنوع وثراء المعارف والفنون. فقوة مناهج التعليم والتربية تتأسس على خلق وتهيئة أناس قادرين على التأمل والحس الجمالي، فيما قسر وقصر وعهر وذعر مناهجنا ونمطيتها الجاهزة الجامدة لم تفتح أي باب في هذه الجهة. ثقافة النقل والتلقين هي السائدة منذ عقود رديئة وما على الجمهور سوى إعادة «الذكر» عن ظهر قلب! وبمثل هذا التوافق الأعمى المعيق العنيف بين جمهور الفيلم ومخرجه يغدو الجدال صِفْراً ويصير الكلام، أسّ النضارة والوجود، مع النقاش عقماً جديداً يضاف إلى عقم «نبض الشارع» البــائس المـهان المخيف. ثمة توازٍ مشبوه، أو تواطؤ يخدم ويدعم بقاء وتكريس الواقع على حاله من التشيؤ والخواء…؟!
علي جازو: السفير ، {الريف والمدينـة فـي السـينما السوريـة ..الزمــن ليــس زمــن ملائكــة }




