فــي زحــام الجوائــز العربيــة
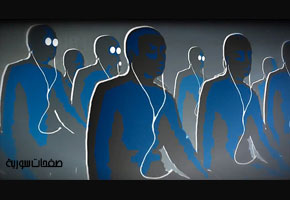
نبيل سليمان
جائزة نجيب محفوظ للكاتب العربي.. جائزة القدس.. جائزة مؤسسة الفكر العربي للكتاب.. جائزة أحلام مستغانمي.. جائزة محمد الماغوط.. جائزة سلطان العويس.. جائزة مبارك.. وهذا كله ليس (عجقة) سير. هذه (عجقة) الجوائز العربية.
ليس الزحام دائماً بمذمة أو سوء. قد يكون علامة الوفرة، كما هو شأن السيارات الجديدة في سورية خلال العقد الأخير، وبعد قحط عقود. وقد يكون الزحام علامة ابتهاج كالذي يعقب مباراة استثنائية في كرة القدم، على غير الطريقة الجزائرية المصرية. بيد أن الزحام يورث أيضاً عرقلة وضحايا وجعجعة بلا طحن وخسائر وحوادث و… وفي زحام الجوائز العربية من كل ذلك نصيب يطّرد باطرادها، حتى بلغ ما بلغ في هذا الموسم الذي تتوّج بجائزة نجيب محفوظ للرواية وبالقائمة القصيرة للبوكر العربية.
أما الأولى التي تمنحها الجامعة الأميركية في القاهرة، والتي ذهبت هذا العام إلى خليل صويلح عن روايته (وراق الحب)، فقد بشّرتُ الفائز بها في باريس منذ ثلاث سنوات. ولئن كانت هذه الجائزة متواضعة مالياً، فهي، كالبوكر العربية، تفتح أمام حاملها صندوق الترجمة العجائبي. وقد رافقت الجعجعةُ إعلانَ القائمة الطويلة للبوكر العربية هذا العام، قبل أن يهدأ ما رافق الإعلان عن حامل الجائزة في آذار الماضي، وبخاصة ما كان من انسحاب رياض الريس والتنازع على أهلية يوسف زيدان وفواز حداد للفوز.
قبل المضيّ قدماً مع البوكر أشير إلى أن الشاب السوري سامر الشمالي كان قد فاز بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة هذا العام. وبفوزه افتتح المؤتمر الأول للقصة القصيرة في القاهرة، والذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة مطلع الشهر الماضي. وقد تتوج المؤتمر بذهاب جائزة القاهرة للإبداع القصصي في دورتها الأولى إلى زكريا تامر. وكان أن كتب جمال الغيطاني منتقداً تكرار الأسماء في لجان التحكيم، والعلم المسبق بفوز زكريا تامر.
على غير العهد بالحيدة والهدأة اللتين اشتهر بهما جمال الغيطاني، بدا هذه المرة. فلجنة التحكيم في جائزة زكريا تامر كان فيها تسعة أعضاء يشاركون في أي من لجان التحكيم في القاهرة لأول مرة، واثنان سبق لهما أن شاركا هما جابر عصفور ومحمد شاهين. أما تطابق قرار لجنة التحكيم مع ما كان شائعاً، فلا يحتاج إلى غمز ولا إلى لمز، ما دام زكريا تامر مرشحاً. فعلى الرغم من وجود مرشحين أكفاء مثل بهاء طاهر ومحمد البساطي وأحمد بوزفور وسواهم، إلا أن أياً منهم لم يكن له المنعطف الخاص في تطور القصة العربية القصيرة، مما كان لزكريا تامر، عدا عن مزية الإخلاص لهذا الفن، واستمراره في التألق به. ولذلك كان عمل لجنة التحكيم التي تشرفت بعضويتها، سلساً. وجاء القرار بالإجماع على العكس مما أتوقعه للدورة القادمة أو لتاليتها، لأن المنافسة ستحتدم بين إنجازات متقاربة، مما قدم ـ على سبيل المثال ـ محمد خضير وأحمد بوزفور، أو مما قدم ابراهيم أصلان وجمال الغيطاني.
يلح عليّ في هذا السياق أن أكرر أن أول لقاء جمعني بزكريا تامر كان أثناء مؤتمر القصة هذا. وقد كان يمكن للقاء أن يكون منذ أربعين سنة مضت، على الرغم من الجفاء الذي أورثنا إياه كتاب (الأدب والأيديولوجيا في سورية ـ 1974) والذي وضعته مع المفكر الراحل بو علي ياسين. وبين غمضة عين هي زمن المؤتمر، وغمضة عين تلت في ندوة في دمشق حول الرواية الفلسطينية، انسكنتُ بزكريا تامر الإنسان كما سكنني إبداعه منذ (صهيل الجواد الأبيض). وفجأة، رجّتني رسالة منه بالموبايل صباح 17 / 11 / 2009 هذا نصّها: (فزت بجائزتين: الثانية جائزة القصة بالقاهرة والأولى صداقتك ومحبتك). وها أنذا أذيع الرسالة، ليس فقط لأتباهى بها، بل لأضرب بها مثلاً ضد الجعجعة التي تطّرد ملازمتها للجوائز العربية في زحامها المطّرد. ومن ذلك ما كتبه الروائي الصديق ابراهيم عبد المجيد حول القائمة البوكرية الطويلة التي استثنيت منها روايته، فقامت قائمته، وكتب ما أربأ به عنه ، فلم يكتف بالتشكيك في لجنة التحكيم، بل عدّ الأمر مؤامرة ضد الإبداع الروائي في مصر، كرمى لعيني رواية علوية صبح (اسمه الغرام). وجعل ابراهيم المؤامرة تنتسج بإحكام ومكر بين التحكيم في مهرجان الـ 39 والتحكيم البوكري، حتى كادت أن تترجّع في كتابته أصداء مباراة الشؤم المصرية الجزائرية، وهو الترجيع الذي بلغ ما لا يصدق فيما كتبه يوسف زيدان: لماذا يا يوسف؟ لماذا يا ابراهيم؟
سلاح ذو حدين
لست هنا بالذائد عن حمى التحكيم في أية جائزة، حتى لو كانت مما شاركت في تحكيمها أو فزت بها. بل قد يكون لدّي درجة أكبر من الاعتراض هنا أو هناك، ولكن هذا أمر والجعجعة التي قد يكون فيها السباب كما التشكيك في النزاهة والأخلاق، أمر. ففي مهرجان الـ 39 عبّرت صراحة للمبدعين الصديقين عبده وازن وعلوية صبح عن اعتراضي على إبعاد الروائية السورية لينا هويان الحسن من الميدان. وكان من قبل اعتراضي أكبر فأكبر على أن يتولى رئاسة لجنة التحكيم علاء الأسواني، حتى لو كان الأمر شرفياً أو شكلياً. فرواج رواية فلان أو اصطخاب شهرته بحق وبغير حق، لا يجيز له تلقائياً أن يخوض في التحكيم. وبصدد البوكر العربية أحسب أنها فتحت على نفسها الباب عريضاً هذه المرة. ولست أدري أية مصادفة تجعل رياض الريس ينسحب احتجاجاً منذ تسعة أشهر، وشيرين أبو النجا تنسحب بالأمس (ثم تعود أو لا تعود). أما الشاعر المبدع سيف الرحبي، فلست أدري ما الذي رمى به في هذا الزحام، وهو الأرق من نسمة، أم تراه هرب من التحكيم في جوائز الشعر ليقع في فخ التحكيم الروائي؟ ومهما يكن، ففي زعمي أن ليس للصديق سيف ولا للشاعر محمد بنيس من قبل ولا لأدونيس ـ مثلاً ـ من بعد أن يحكّم في جائزة للرواية، إلا إذا خلا المشهد الروائي والنقدي العربي من الجديرين بأن يحكّموا. ويبقى السؤال محرجاً وقائماً عن تأثير الإعلام أو تأثير الرأي العام في التحكيم، كما تردد عن استبعاد رجاء عالم من جائزة نجيب محفوظ للرواية، أو استبعاد علوية صبح من القائمة البوكرية القصيرة، لكأنما أراد التحكيم توكيد حيدته فنابذ الإعلام الذي زكّى بقوة العالم وصبح، ومثل هذا، إن صحّ، بدعة لا يعرفها التحكيم وأقرب مثال لذلك هو الغونكور لهذا العام.
للقول هنا ـ ربما ـ أن يتابع إلى أنه قد آن الأوان كي تفسح الأسماء المتواترة في التحكيم لخبرات جديدة، ولكن بدون الغمز الذي سبقت الإشارة إليه في كتابة جمال الغيطاني. فمن الأسماء المتواترة ما بات (ماركة مسجلة) في زحام الجوائز، يقترح الجائزة، ويوقع في فخ اقتراحه ممولاً، ويؤسس الجائزة، ويطلقها، ويحكّم فيها، ويلهط من دولاراتها ما يلهط، حتى ليبزّ الفائز بها. ولقد كان جابر عصفور أثناء رئاسته للمجلس الأعلى للثقافة يحسن فعلاً في دورات مؤتمر القاهرة للإبداع الروائي خلال عشر سنوات، إذ لم يكتف في تشكيل لجان التحكيم بالعشرة المبشرة، بل جاء بآخرين أكفاء من الهامش إلى المتن. وليس تخفى المغامرة هنا، إذ سرعان ما تبدأ الجعجعة، وقد كان ذلك حقاً، حين ظهر في لجنة التحكيم مثلاً رشيد الضعيف أو جمال شحيد أو… والخبرات الجديدة إذن ضرورة كضرورة تجديد أو تطعيم الأسماء المحكّمة في الجائزة الواحدة من دورة إلى دورة. وهنا أسوق ما خبرته بنفسي من التحكيم في جوائز مهرجان المزرعة في مدينة السويداء ـ مدينة أسمهان وفريد الأطرش ـ والتي تتوزع سنوياً على القصة والرواية والشعر والمسرح والفن التشكيلي والنقد، ويموّلها المهندس السوري المقيم في الإمارات: يحيى القضماني. فالفروع كثيرة، ولكل فرع لجنته الثلاثية، وهكذا كان وسيكون أن يأتي الدور في التحكيم لمن ليس أهلاً له، ما دام المنظمون يحرصون على ألا يتكرر المحكمون إلا بعد عدد من الدورات. وهكذا يبدو الأمر سلاحاً ذا حدين، ولا بد فيه من المرونة والشفافية والواقعية أيضاً.
لا يفرق زحام الجوائز بين صغيرها وكبيرها، ولا بين الأهلي أو الرسمي منها. وفي سورية ـ كما في أكثر من بلد عربي، في حدود علمي ـ تتدافر الجوائز في المراكز الثقافية وفروع اتحاد الكتاب في المحافظات. وهذه الجوائز متواضعة مادياً بعامة، وأغلبها متواضع معنوياً. ومن طرائف ـ أي مخازي ـ ما شاهدت منذ أسابيع أن جائزة للقصة القصيرة في دورتها التاسعة عشرة في محافظة نائية وصغيرة، قد تدافع إليها كاتب وكاتبة من محافظة ساحلية، للأول أكثر من عشر مجموعات، وللأخرى أكثر من خمس، عدا عن كذا رواية، فالجائزة لا تحدد سناً للمشتركين. وكانت المفاجأة أن فاز الكاتب الستيني بنصف الجائزة الثالثة، وقيمتها ما يعادل مئة وخمسين دولاراً، ولقد رأيته يجري لاهثاً في أروقة (قصر الثقافة) ليحصل المبلغ، ولم يكن حظ الكاتبة بأفضل، إذ ناصفت على الجائزة الثانية، وبما يعادل مئتي دولار: يا للعار!
يا للعار، ما دامت جحافل من الكتاب والكاتبات تريق ماء الوجه في زحام الجوائز. ومع ذلك، بل بالضد من ذلك، يعلن هذا الزحام أسماء جديدة جديرة، أو يكرس أسماء. فالمسابقة التي تنظمها وزارة الثقافة السورية ـ على خجل، وبتردد ـ في الرواية، مثلاً، أعلنت بالجائزة التي تحمل اسم حنا مينة عن كاتبتين هما روزا ياسين حسين وعبير إسبر. وكانت الجائزة التقديرية لاتحاد الكتاب قد ذهبت في دورتها الأولى إلى الروائي الكبير الراحل هاني الراهب منذ أكثر من ربع قرن، ثم تمّت إماتة الجائزة ببراعة في العهد المديد لعلي عقلة عرسان في رئاسة الاتحاد، ولا يزال موت الجائزة مستمراً من بعده. كما تمت ببراعة إماتة جوائز المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، منذ تأسيسه قبل قرابة نصف قرن. وبفضل ما تقدم تفتقر سورية إلى جائزة مرموقة. وربما كان ذلك من أسباب تدافع الأصوات السورية الجديدة بخاصة إلى زحام الجوائز العربية، وفوزها بنصيب وافر سنة بعد سنة، وحسبي أن أضرب مثلاً بجوائز سعاد الصباح أو بجائزة الإصدار الأول في الشارقة.
زحام جوائز في مصر
بالمقابل، نرى في مصر زحاماً لجوائز الدولة وعليها، التشجيعي منها والتقديري، وجوائز التفوق، وصولاً إلى جائزة مبارك. وما من عام إلا وتتزلزل جنبات المجلس الأعلى للثقافة بالزحام. وقد تقدّم (القطاع الخاص) إلى هذا الزحام، إما بمشاركة (القطاع العام) كما في جائزة رجاء النقاش في النقد الأدبي، والتي ينظمها اتحاد الكتاب في مصر بالمشاركة مع دار الشروق، أو بدون مشاركة كما في جوائز ساويرس في مصر أو جوائز نبيل طعمة ودار الفكر في سورية أو جوائز عبد الله باشراحيل في السعودية، أو جوائز كومار في تونس…
في الجعجعة المرافقة لزحام الجوائز أن قدراً كبيراً منها مما يقدمه (القطاع الخاص) له قدر كبير من المصداقية، على العكس من العديد من جوائز المؤسسات الرسمية. وسواء صح ذلك أم لا، فقد تحقق للعديد من الجوائز الحكومية وغير الحكومية، في منطقة الخليج العربي، قدر كبير من المصداقية، سواء ما بات منها راسخاً وعريقاً مثل جائزة مؤسسة التقدم العلمي في الكويت أو جائزة سلطان العويس في الإمارات أو جائزة الملك فيصل في السعودية، أم ما ظهر منها للتوّ، مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب. وإذا كانت أرقام جوائز منطقة الخليج تظل فلكية مهما صغرت، فمصداقيتها كما هي مصداقية الجوائز بعامة تتأكد، أولاً وأخيراً، بفضل لجان التحكيم: الخبرة والنزاهة والفاعلية، والمعايير التي تتبعها في التحكيم، فضلاً عن نواظم وتمويل وإدارة الجائزة، فبفضل ذلك كله تتأكد مصداقية هذه الجائزة أو تتهلهل مصداقية تلك.
لقد وفّر زحام الجوائز العربية لأعداد متزايدة من الأصوات المبدعة الجديدة ما لم يتوفر لنظرائهم من الأجيال السابقة. وفي هذا حافز كبير كما قد يكون فخاً كبيراً. فإذا كانت الجائزة المحترمة تؤكد الاعتراف بحاملها وتيسّر له بحبوحة مالية، وتفتح له صندوق الترجمة العجائبي، فهي أيضاً قد تطيش صاحب الرأس الخفيف، مهما تكن موهبته وأهليته كبيرتين. وهذا لا يعني أن الفائز المخضرم أو العجوز في منجاة من عوسج الجوائز. ومن جهة أخرى، تقوم مفارقة أخرى في التباس التجاوز والتجريب والتجديد بقتل (الأب)، بينما يمسك (الأب) بالجائزة التي تكرس الاسم الصاعد والواعد، ولا بد لهذا الاسم من اعتراف الأب المرفوض، ولكن هذا ليس امتيازاً خاصاً للجوائز العربية، ولا لصراع الأجيال العربية.
لقد تناقلت الأنباء الثقافية للتوّ أن الروائي الليبي صالح السنوسي قد اعتذر عن قبوله جائزة الفائح التقديرية للآداب، وقيمتها المادية 25000 دينار ليبي. ولا يزال يدوّم في الفضاء الليبي منذ الصيف رفضُ الروائي الإسباني غويتسولو لترشيحه لجائزة القذافي التي نافست الجوائز الخليجية (200000 دولار أميركي). كما لا يزال يدوّم في الفضاء المصري، بل العربي، منذ سنوات رفض صنع الله ابراهيم لجائزة القاهرة للإبداع الروائي.
وإذا كان أي رفض من هذا القبيل يحتاج إلى شجاعة أكبر فأكبر، فإن النظر في أسباب الرفض يحتاج إلى شجاعة مماثلة، كما هو شأن النظر في علل الجوائز العربية جميعاً، إلا إذا كان ما يرافق الزحام من خسائر وضحايا وعرقلة غير مهم، لا في السير ولا في الجوائز.
(كاتب سوري)
السفير الثقافي




