توقيت دقيق
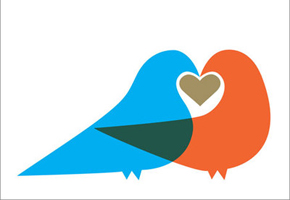
غاية بورالي أوغلو
ماغريت، امرأة حزينة.
لقد قالها في توقيت، لم أملك معه إلا الردّ بالموافقة. وما إن حصل على موافقتي حتى فتح الباب وخرج، بل قفز خارجاً. لم أجرؤ على القول إنني أريد مرافقته. المنشفة تلفّ رأسي والبرنس يحيط بجسمي العاري الذي يقطر منه الماء. كيف لي أن أقول له إنني أريد مرافقته؟ خرج ببساطة، ولم يسألني على أي حال عما إذا كنت أرغب في مرافقته. لا بد أنه انتظر هذه اللحظة بالذات، اللحظة التي لا أملك فيها خياراً آخر غير الرد بالموافقة.
الحق أن ما فعله شيء وضيع. لا بد أنه تحسّب لهذا الموقف بدقة. لعله كان يتحيّن هذه الفرصة منذ وصولنا، أعني فرصة دخولي الحمّام. سأبتهج كثيراً إذا كان الأمر على هذا النحو، فمعنى ذلك أنه ينتظر هذه الفرصة منذ ثلاثة أيام كاملة. لأنني لم أغتسل منذ ثلاثة أيام. فالجو بارد في الليل، وأخشى الإصابة بالبرد إذا اغتسلت. أضف أنني أحب البقاء والملح يغطي جسمي. ملح البحر والعرق يمتزجان معاً، فيصبح جسمي كالقديد. لعلني كنت متوجسة مما سيقع. ما الذي دفعني الى الاستحمام! لا بد أنها رغبتي في الظهور بمظهر من يحب النظافة. كان في وسعي الامتناع عن الاغتسال يوماً إضافياً بل يومين. وكان سيضطر الى الانتظار يوماً أو يومين إضافيين. آه، كم كان الأمر ليكون رائعاً!
وما الفرق إذا انتظر يوماً أو يومين، فهو سيجري اتصاله على أي حال.
ترى هل أتمكن من اللحاق به إذا ارتديت ثيابي فوراً وخرجت في أعقابه؟ لو أنني أركض وأمسك به متلبساً في حجرة الهاتف العمومي، وأخطف السماعة من يده فأغلقها بصخب، وأقول له: “هيا امشِ! لا توتر أعصابي! نحن نحبّك فلا تتصرف بغباء!”. إذا خرجت قبل تجفيف شعري فسوف أمرض. لديَّ التهاب في الجيوب الأنفية. أخطر ما يمكن أن أفعله هو الخروج بشعر رطب. فإذا مرضتُ، كان ذلك نهاية كل شيء. أن أصاب بالمرض، فهذا يعني دمار كل شيء، لأنني سأضطر، في هذه الحال، إلى الاضطجاع طوال اليوم، ويخرج هو كل يوم ليجري اتصاله. من يستطيع تحمل ذلك؟ أنا شخصياً لست قادرة على التحمل. سيجعلني ذلك أموت. ليس بفعل التهاب الجيوب.
ليتني اصطحبتُ مديتي، لأمكنني أن أقطع شريان معصمي. لكنت ملأتُ حوض الحمّام بالماء وتمددتُ فيه ثم قطعتُ معصمي وغطّسته في الماء.
ترى هل يتألم الإنسان حين يقطع معصمه؟ لم أصب بأي جرح في أي مكان من جسمي. ليست لديَّ أي تجربة في هذا الصدد. حين كنت صغيرة، تآخيت بالدم مع إحدى صديقاتي، بأن غرزت رأس إبرة في يدي، فآلمني ذلك كثيراً. هذه هي خبرتي الوحيدة في حياتي. إذا كان غرز الإبرة مؤلماً إلى ذلك الحد، فكم يكون فظيعاً قطع المعصم؟ ترى كيف يفعلون ذلك ببساطة؟ صديقتي التي تآخيت معها في الدم، اتضح لي أنها لا تستحق التآخي، فقد مرّت السنوات ولم ألتق بها. لقد ثقبت بشرة يدي سدىً.
لو أنه عاد فوجدني منتحرة، فكم سيدهشه ذلك! أعني إذا لم أمت بعد محاولة الانتحار، فسوف يدرك قيمتي، ويدرك أيضاً كم أنني أحبّه. هذا جيد. لا أريده أن يشفق عليَّ، بل أن يرى الحقيقة. لكي لا يهدر وقته في علاقات سخيفة. أي لمصلحته هو. لمصلحته ومصلحتي معاً. على المرء أن يتحرر من العلاقات السابقة عند نقطة معينة. فالحبيبة السابقة هي حبيبة سابقة، وعليها أن تبقى في الماضي. أما إذا حملتها معك فسوف تسبب تراكماً. يكون للمرء، في حياته، الكثير من الحبيبات السابقات. إذا حملهن جميعاً برفقته، فسوف يتعين عليه الاتصال بواحدة منهن كل دقيقة. أضف أن عليه أن يفعل ذلك خفيةً عن الأخريات. على جميع الحبيبات السابقات دخول الحمّام في اللحظة نفسها، ليتسنى لك الخروج للاتصال بواحدة سابقة. بما أن هذا لا يمكن أن يحدث! ثم كل الناس لديهم علاقات سابقة. فإذا اتصل كل شخص بعلاقته السابقة، فلن يتاح له القيام بأي عمل آخر. هل أتصل أنا بعشّاقي السابقين؟ هم أيضاً لا يتصلون بي. لا أعرف لماذا لا يفعلون. ربما لأن كل علاقاتي السابقة انتهت نهاية سيئة. والحال، أن المرء يرغب في أن يسأل عنه الآخرون. ذلك يمنح شعوراً دافئاً. الحبيب هو حبيب دوماً. يخلق الحب بين شخصين حميمية لا يشبهها شيء، حتى لو اتصل الأمر بعلاقة سابقة.
لو كنتُ حبيبة سابقة له، أتراه كان اتصل بي أيضاً؟ لكنني لا أريد أن أتقادم. مهما قلّبت الأمر على وجوهه، فإنه لأمر سيئ أن تكوني حبيبة سابقة. إذا بتِّ سابقة، فهذا يعني أن ثمة جديدة. فكّري معي: الشعر الذي كنتِ تشمّين رائحته، تشمّه الآن أخرى، والشفتان اللتان اعتدت على تقبيلهما، تقبّلهما الآن أخرى. ترى هل كان ليتصرف معها بالطريقة نفسها، هل كان يغمض عينيه حين يضاجعها كحاله معي؟ لعله لا يزال يرغب بها، أليس هذا وارداً؟ من الواضح أنه لا يزال مهتماً بها على الأقل. لولا ذلك لما تركني بشعري المبلل وخرج للاتصال بها. يشعر نحوها بالحميمية، ولعله لا يزال يحبها. ذهنه مشغول بها، لذلك يتصل بها. يمضي الوقت معي لكنه يفكر في أخرى. من يدري ما الذي يتحادثان فيه الآن؟ “يا روحي، يا قردتي الصغيرة، أحبك كثيراً!”. ربما لا يخصّني وحدي بعبارة قردتي الصغيرة. ربما يقولها لكل حبيباته السابقات. الواقع أنني لا أشبه كثيراً قردة صغيرة. صحيح أن قامتي قصيرة جداً، وفي ظهري تحدّب طفيف، لكني مع ذلك لا أشبه قردة. عليَّ أن أقف باستقامة، عليَّ أن أعتاد الوقوف باستقامة. كنت أشكو في طفولتي من مدّ النظر، فكنت أنحني على دفتري كثيراً لأتمكن من الرؤية. هذا هو سبب التحدب في ظهري. طالما ضربتني أمي على رأسي بطبق الميلامين منبهةً إيايَ ألا أنحني. لو أنها أخذتني إلى طبيب، بدلاً من الضرب على رأسي، لاكتشفت مدّ النظر عندي، وما احتجت إلى ذلك الانحناء كله، ووقفت باستقامة. لو جرت الأمور على هذا النحو فلربما لم يخاطبني بقردتي الصغيرة. الحق أنني قردة صغيرة، ولا تسوؤني مخاطبته لي بها، بل إنها تمتعني. ليخاطبني بها، لا اعتراض لي على ذلك، على ألاّ يخاطب بها غيري. ألا يقول لحبيبته السابقة، على التلفون، يا قردتي الصغيرة. فإذا قال فإن العبارة تفقد كل خصوصية. لا يصح أن تخاطب كل الناس بالعبارة نفسها، فإذا خاطبت واحدة بقردتي الصغيرة، فعليك أن تخاطب غيرها بعبارة أخرى. لتقل لها مثلاً إبليسي الصغير أو قطعة الحلوى أو يا سكّرة، وما إلى ذلك. لا… السكّرة ليست مناسبة، فهي مبتذلة جداً. يجب البحث عن شيء أكثر تميزاً. أنا واثقة بأن لديه ما يناديها به. فهو شخص مبدع، بخلافي. فأنا أبذل جهداً جهيداً، ومع كثير من الحرج أقول “أحبك” لأن أي شيء آخر لا يخطر في بالي. حتى هذه العبارة طالما خجلت من التفوّه بها. وهذا ما يثير غضبه. وهو على حق طبعاً، فهو ينتظر مني كلاماً حلواً، ولكن لا حياة في من تنادي. أما هو فما أسرع ما يبتكر. من يعلم ما الذي يقوله لها الآن؟ قوس قزحي… حمّصتي البيضاء… يا ذات الأذنين كثمرتي بندق. سأقتله! بحركة واحدة سأقتله. أقتله بدلاً من قتل نفسي. سوف أستل القضيب المعدني المتخلّع للسرير، فهو يصدر صريراً مزعجاً أثناء المضاجعة، فيذهب بكل متعتها. سأستل تلك القطعة المعدنية وأكمن وراء الباب. وحين يفتحه ويدخل، أضربه بها على رأسه. سوف يموت على الفور ولن يشعر بأيّ ألم. الحق أن انتزاع القطعة المعدنية من السرير فكرة جيدة. لعله لا يصدر صريراً بعد ذلك. فهو يشتت تركيز المرء تماماً، ويستقطب انتباهه. من المحتمل أن قاطني الغرفة تحت يسمعون الصرير، وهذا شيء غير لائق. ثمة شيء آخر، هو أن الصرير لا يصدر بصورة متزامنة مع حركات الشريكين. تندفع إلى الأمام، على سبيل المثال، فلا يصدر أي صوت. في اللحظة التي تتراجع فيها إلى الوراء يندلع الصرير! شيء يثير الأعصاب.
حسناً فعلت بالتفكير في القضيب المعدني. ليتني فكّرتُ فيه من قبل.
الباب يقرع!
الباب يقرع. الباب يقرع. لا بد أنه هو. لو أنقضّ على رأسه بالقضيب المعدني وينتهي الأمر. لم أرتد ثيابي بعد، ما زلت في البرنس… وهو فضلاً عن ذلك بلا زنّار! حين أرفع القضيب المعدني في الهواء، فسينفتح البرنس من الأمام. وضع غير محترم سيدفعني الى الخجل. ماذا لو أحكمت غلق فتحة البرنس بيد ورفعت القضيب المعدني بالأخرى؟ إذا لم أضرب بما يكفي من القوة فسأواجه فضيحة. سوف ينقضّ عليَّ صارخاً: “أيتها المتخلفة عقلياً!”، ولن أملك كلمة أقولها ردّاً عليه. لا أستطيع تبرير أي شيء. ستكون فضيحة تامة.
لم يكن هو الطارق، بل خادمة الغرف. صرفتها قائلة لها: “لست مستعدة الآن. اصرفي النظر اليوم. شكراً لك”. لم تظهر أي إلحاح، بدت موافقة على التأجيل بجماع قلبها. عمل أقل بالنسبة اليها. نظرت ببلاهة إلى شعري المبتل وانصرفت. عليَّ أن أجفف شعري. لا يناسبني المرض أبداً في هذا التوقيت.
الأفضل التحدث في الموضوع بهدوء وعقل، من غير الاستسلام للهلع. الكلام كفيل حل كل المشكلات. على المرء أن يتحدث إلى الشخص الذي أمامه ويعبّر له عن نفسه. عليه أن يتحدث عما يشعر به ولماذا، وعن الأسباب الكامنة خلف تلك المشاعر، وعن ضروب السلوكيات غير السوية المتراكمة في ماضيه، والمشكلات النابعة من تربيته، ورضوض طفولته، والأحداث البارزة التي وقعت له. بيد أنني لا أملك الكثير مما أحكيه بهذا المعنى. لقد عشت طفولة سعيدة للغاية، ونشأت في حي صغير، داخل بيت تحيط به حديقة، كنت أركض وألعب في الشارع طوال النهار. كنت مجتهدة في دراستي، ولم أحصل على درجات متدنية في دروسي، وكان معلّميّ يحبونني. كان أبي وأمي شخصين متوسطي الحال، لا أتذكر حدوث مشاجرات كبيرة بينهما. ثم المدرسة المتوسطة فالثانوية، حيث لم تقع أحداث مهمة. كان جميع زملائي، في المرحلة الثانوية، ينقسمون مجموعات يمينية ويسارية، ينهمكون في مناقشات ساخنة في ما بينهم. وكانوا يستيقظون في الصباح المبكر ويكتبون الشعارات على سياج المدرسة، ويرابطون أحياناً أمام باب المدرسة ويقولون لنا: “لا دوام في المدرسة اليوم”، وكنا نلتزم ما يطلبون، فنعود أدراجنا إلى البيت. وأحياناً كانوا يجتمعون معاً ويهتفون: “حرب حتى النصر!” أو “الموت للفاشية!” أو “لعنة الله عليكم!”… لا… هذه العبارة الأخيرة لم يهتفوا بها، لكنهم كانوا يعبّرون عن غضب مماثل. وكان الغضب يدفعهم أحياناً إلى القتال في ما بينهم. لا أعني سجالاً لفظياً، بل كانوا ينكلون بعضهم ببعض، ثم يختفون عن الأنظار. دخلوا السجون جميعاً، ومات بعضهم. لقد راقبتهم دائماً من مسافة، ولم أتورط في ما كانوا فيه. لم أكن تلميذة متفوقة، لكني لم أرسب في صفي البتة. لم أرسب حتى في الأول ثانوي. ودخلت الجامعة من الاختبار الأول. صحيح أنني لم أحصل على الفرع الذي تصدّر قائمة تفضيلاتي، لكني لم أبق خارج الجامعة. تخرجت بعد أربع سنوات، أي كما ينبغي تماماً. ثم وجدت عملاً. كل شيء تمام.
إذاً لماذا أنا هكذا؟ كيف لي أن أشرح له سبب شعوري بالضيق، إذا لم أتمكن من شرحه لنفسي؟ ليكن… عليَّ، مع ذلك، أن أحاول. ربما يحسن بي ألا أتعمق في الموضوع كثيراً فلا أحدثه عن طفولتي وما إلى ذلك. لأن هذا القسم من الحديث قد يكون مملاً. لطالما خشيت الوقوع في الأحاديث المضجرة. طلبوا مني في إحدى المرات أن أشرح مفهوم إدارة الجودة الكلية في المصنع، فغطّ جميع العمال في النوم. بل إن أحدهم أخذ يشخر. رأيت زميله يلكزه ليستيقظ. استيقظ العامل الذي كان يشخر خشية أن يصبح موضع سخرية زملائه، وفتح عينيه على اتساعهما. أدركت من حركة فمه كمن يلوك شيئاً، أنه غرق في النوم إلى درجة تراكم معها اللعاب في فمه. لكن الأمر مختلف الآن، ولا يشبه في شيء مفهوم إدارة الجودة الكلية. موضوع الحديث الآن هو أنا، مشاعري أنا، كبريائي الجريحة المحطمة، الحزن العميق لشخص مخدوع، ذكاء عاطفي أسيء فهمه! قلب متعطش للحب.
غير معقول! تتركني، في غرفة الفندق، بشعري المبلل، وتذهب للاتصال بحبيبتك السابقة! حسناً، قد يكون شعري الآن جافاً، لكنه كان مبللاً حين خرج. تلك اللحظة هي المهمة. لو لم يكن شعري مبللاً في تلك اللحظة لكان في وسعي أن أقول له: “سأخرج معك”. في هذه الحالة ما كان في إمكانه الاتصال بحبيبته السابقة. لكنا تنزهنا قليلاً ثم عدنا معاً إلى الفندق، ولما حدث شيء. لكنا عدنا إلى غرفتنا ومارسنا الحب. أما الآن فقد فقدت القدرة على الاستمتاع بأي شيء، لا طاقة لي على مجرد الكلام، ناهيك بممارسة الحب. ربما يمكنني الانطلاق من هذه النقطة في التحدث إليه. سوف أقول له، إذا فقد المرء الطاقة على فعل أي شيء، فلن تسير الأمور على ما يرام. سأقول له إن تحطم القلب يمكن أن يؤدي إلى جراح كبيرة إلى حدّ لا يصدَّق. سأقول له إن الإرهاق المتراكم يعدم الحماسة في القلب. بل في وسعي أن أتمادى أكثر فأهدّده بصورة طفيفة بالقول: “إذا واصلتَ ما أنت فيه، فستخسرني”.
ماذا لو ردّ عليَّ بالقول: “لا أكترث بذلك”! لا يمكنني التراجع في هذه الحالة. كيف لي أن أقول له: “لا… لا… كنت أمزح، وهل يعقل أن تخسرني؟ في إمكانك دائماً أن تجري اتصالاً تلفونياً كلما خرجتُ من الحمّام. لا يزعجني ذلك البتة. لا أهمية لهذا”. يحسن بي أن أتخلى عن فكرة التهديد. لعل التحدث إليه ليس بالفكرة الجيدة. سوف أجلس عابسة، وسوف يفهم. عليه أن يفهم. لن أتفوّه بكلمة، وسوف يفهم. إذا طرح عليَّ سؤالاً، امتنعتُ عن الجواب، وإذا نظر إليّ أدرتُ وجهي ونظرتُ بشرود من النافذة. بل يمكنني إطالة الموقف أكثر بالزعم أنني أعاني من ألم في بطني، وتناول الكومبينيزان أو ما شابه. بل يمكنني التقيؤ أيضاً إذا اقتضى الأمر. في هذا الموقف سيبدي اهتمامه من كل بد ويسألني عما أشكو منه. في تلك اللحظة سينطوي جوابي على أهمية كبيرة جداً. عليه أن يتضمن نوعاً من الهجوم، وأن يلقي باللائمة عليه. يجب أيضاً أن يُظهر له جوابي مدى استيائي من الوضع. وأن يعبّر عن حبّي له. على الجواب أن يكون مختصراً وكثيفاً. يجب تجنّب الحديث الطويل. يجب إصابته مباشرةً في القلب. ضربة واحدة تصيب الهدف تماماً، أعني الجواب. لعله من الأفضل طرح الجواب بصيغة السؤال. هكذا مثلاً: “هل يعجبك ما تفعله؟”. تعبير المرء عن نفسه بصيغة السؤال، طالما كان مؤثراً. فبهذه الطريقة لن تتحملوا المسؤولية لأن كلامكم يخلو من إطلاق أحكام، وتوصلون، في الوقت نفسه، ما أردتم إيصاله الى الشخص الذي تخاطبون. هذا حل في منتهى الذكاء.
حسناً، وأنا ما الذي أريده أن يقول لي؟
لا بأس الآن في أن أرتدي ثيابي. عليَّ ألا أستقبله في البرنس فيتميّع الموقف. عليَّ ألا أرتدي شيئاً مميزاً جداً. يجب أن أولّد لديه الانطباع بأنني ارتديت ما وقعت عليه بمحض المصادفة، من غير اختيار وتمحيص. لئلا ينتبه فوراً إلى أن ثمة شيئاً غير طبيعي. ففي هذه الحال سيكون كلامي أكثر تأثيراً.
يمكنني أيضاً أن أمسك بمجلة أو شيء ما. لا، لا أستطيع الإمساك بمجلة، لأنه لا مجلات في الغرفة. يمكنني حمل كتاب في يدي. بيد أن الكتاب الذي عندي يحمل عنوان رجل أحلامي. ليس مناسباً البتة. فمن شأنه أن يعطي الانطباع بأنني أريد، بوساطة الكتاب، إبلاغه رسالة، وهذا انطباع غير صحيح أبداً. الأفضل ألا أتظاهر بقراءة كتاب. ولكن إذا بقيتُ بلا شيء يشغلني، فسأبدو كما لو كنت جالسة في انتظاره. عليَّ أن أنشغل بشيء ما. وأي شيء يمكن أن أفعله في غرفة الفندق؟ هل يعقل مثلاً أن أمسح زجاج النافذة؟ على أي حال، يجب ألا أبالغ كثيراً. ليس عليَّ البحث عن عمل ذي شأن. أي شيء عادي خفيف سيفي الغرض. كأن أمسح وجهي بقطعة قطن أو أزرّر قميصي أو ألعب بخيط يتدلى من طرفه. لا، هذا يعبّر عن توتر عصبي. الأشخاص الذين يلعبون بالخيط المتدلي من طرف القميص، هم أولئك الذين ينطوون على غضب مكظوم ويعجزون عن التعبير عنه. إنهم شديدو الخطر كقنبلة جاهزة للانفجار.
فتح الباب فجأةً ودخل. معنى هذا أنني لم أقفل الباب بعد انصراف عاملة خدمة الغرف. لم يقل أي شيء. أخذ يبحث عن شيء ما في حقيبة سفره. أخرج علبة كريم ووقف أمام المرآة وأخذ يطلي به وجهه. أخذت نَفَساً عميقاً وقلت له وأنا أنظر من خلال النافذة: “أين كنت؟”. ردّ قائلاً: “سبق وقلت لك، خرجت لأجري اتصالاً”. ها هو الآن يتفحص وجهه بدقة في المرآة. ينظر إلى حبّ الشباب المنتشر على وجهه، بتحريك فمه يميناً شمالاً. سألته وأنا أحاول ألا يرتعش صوتي: “بمن اتصلت؟”. ردّ قائلاً: “اتصلت بأمي”. ثم التفت ونظر إليَّ نظرة ذات معنى. لم أعرف أين أخبّئ تعبير البلاهة المرتسم على وجهي. قال لي: “زرّك مفتوح”. احمّر وجهي وصولاً إلى أذنيّ. سألته، لا بفعل الخجل، بل الحنق: “لماذا لم تتصل بها من تلفونك المحمول؟”. قال وهو ينضو عنه الـ”تي شيرت”: “نفدت شحنة بطاريته كما تعرفين”.
صحيح، فقد نسي جهاز الشحن في البيت. كنت قد نسيت ذلك.
“نعم، صحيح” قلت له. أدار ظهره للمرآة وتفحّص عضلاته لبعض الوقت، بلا مبالغة، كما لو كان يشاهد شاماته. ثم نظر إلى وجهه مرة أخرى. اقترب أكثر ونظر إلى حب الشباب على وجهه. ضغط بأصبعيه على واحدة منها. ثم أخرج شورته من الحقيبة ووضعه فوق السرير. خلع بنطاله. لم يبق شيء آخر يمكن عمله. اقتربت منه واحتضنته واحتضنني. مارسنا الحب بعد ذلك على صوت الصرير المعدني ¶
قصة قصيرة
ترجمة بكر صدقي
النهار الثقافي




