جورجيا: شرارة اللعبة الكبرى في القرن الحادي والعشرين؟
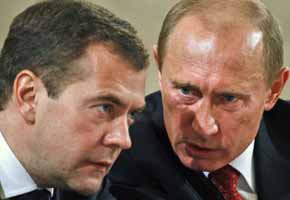
صبحي حديدي
قد يجوز القول إنّ المآل القاتم الذي أفضت إليه رهانات الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي، وكانت أقرب إلى المغامرة القصدية منها إلى الحسابات الخاطئة، … ما هو صحيح أكثر، ربما، هو أنّ المآل ذاته كان خاتمة منطقية ـ وليس البتة نتيجة غير مباشرة، كما يساجل البعض ـ للفشل الذريع الذي لقيته السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الحالية في منطقة القوقاز. ولقد بدأ خطّ انحطاط تلك السياسة منذ مطلع العام 2004، حين ربت الرئيس الأمريكي جورج بوش على كتف الرئيس الجورجي المنتخب ميخائيل ساكاشفيلي، وهنأه على النتيجة الجارفة التي أسفرت عنها انتخابات (كانت، في أكثر من وجه، جديرة بأنظمة الإستبداد العربية وحدها!). ولم يغب عن بال بوش، وهو الابن البارّ للإحتكارات النفطية الكونية العابرة للقارّات، أن يذكّر الرئيس الشاب هكذا: ‘نعلّق الكثير من الآمال على جورجيا الجديدة’، و’ننتظركم بفارغ الصبر في واشنطن، من أجل الشدّ على أيديكم’. لم لا، فالرئيس الشاب ذاك يظلّ ابن الولايات المتحدة وربيب الثقافة الأمريكية في نهاية الأمر، والحمقى وحدهم يغفلون حقيقة الدور الأمريكي في صعوده، على أنقاض إدوارد شيفارنادزة… حليف أمريكا السابق في عهد الـ ‘بيريسترويكا’، وكذلك خلال السنوات اللاحقة كافة. وإذا كان الأخير قد صار طريد الجماهير الجورجية، فلأنّ ساكاشفيلي اتخذ صورة الوليد السعيد للحلم الأمريكي في ناظر جموع بلغ بها السيل الزبى، ليس ضدّ المافيات والنهب المنظّم والفساد العميم فحسب، بل أساساً من أجل لقمة خبز يومية نظيفة.
وكنّا في عداد تلك الفئة التي تساءلت: حسناً، ولكن حتام ستبقى آمال الجورجيين الفقراء معلّقة على الحلم الذي احتكر الرئيس الجديد تجسيده؟ وهل ستطول آجال الانتظار، بالنظر إلى أنّ المعطيات كانت تقول إنّ هذه الجمهورية لن تكون أفضل من أخواتها الجارات، جمهوريات الإتحاد السوفييتي السابقة في البلطيق والقوقاز، المنخرطات في اقتصاد السوق، والذي بات مجرّد تنويع لفظي على التعبير الآخر الأدقّ: ‘الليبرالية الوحشية’؟ وهل ستكون جورجيا الجديدة محض بيدق جديد ينضمّ إلى الشطرنج الكبير الذي يشهد ‘اللعبة الكبرى’ العتيقة، لعبة الأمم والمصالح دون سواها… ودون تبديل كبير، يا للعجب؟ وهل الصلة واضحة، كما عين الشمس، بين أوضاع جورجيا غير المستقرّة، وعراقيل تنفيذ أنبوب النفط العملاق ‘باكو ـ تبليسي ـ سيحان’، القادم من حقول نفط أذربيجان وكازاخستان وبحر قزوين إجمالاً، المارّ في جورجيا بالضرورة، والواصل إلى ميناء سيحان التركي على شواطىء المتوسط؟ وليس من المبالغة القول إنّ في وسع المرء أن يعثر على خلفيات إقتصادية جيو ـ سياسية، كونية أكثر منها إقليمية أو محلية، لقراءة عشرات التطوّرات التي شهدتها وتشهدها بلدان أوروبا الشرقية. وهذا ‘المعسكر الإشتراكي سابقاً’، لم يستكمل بعد نصف العقد الأوّل من ثوراته الديمقراطية ـ الليبرالية، لكنه استعجل الإنقلاب إلى النقائض القديمة بعد أن أضفى عليها أكثر من مسحة واحدة مصطنعة. سياسات القوى الكبرى، قبل مشكلات المجتمع الكبرى، هي الهادي في هذه الأنظمة الجديدة، لأنها ببساطة كانت في رأس الأسباب الجوهرية لصعود تلك الثورات، واتكائها أكثر ممّا ينبغي على الغرب وأمريكا. صحيفة ‘وول ستريت جورنال’، الناطقة باسم كبار رأسماليي الكون، نشرت مقالاً كتبه جوزيف جوفي، رئيس تحرير الجريدة الألمانية المحافظة ‘داي تزايت’، شدّد فيه على المصالح الإقتصادية الستراتيجية الكامنة خلف هذا النزاع الروسي ـ الأمريكي في جورجيا. ولقد اعتبر جوفي أنّ الموقع الهامشي الذي تشغله كلّ من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لا يطمس حقيقة أنهما بمثابة ‘شرارات اللعبة الكبرى للقرن الحادي والعشرين، حيث القضية هي التالية: مَنْ سيحظى بالسيطرة على حوض بحر الخزر، مخزون مصادر الطاقة الأغنى بعد الشرق الأوسط’؟ بالطبع، ليس ثمة سبب واحد يدفع المرء إلى تبرير التدخّل العسكري الروسي في جورجيا، أو اللجوء إلى سياسة منهجية لتأجيج النزعات الإنفصالية في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. غير أنّ الثابت، في المقابل، هو أنّ رهانات ساكاشفيلي (المنضوية ضمن الإطار العريض لسياسات واشنطن، في نهاية المطاف) لم تكن تستفزّ موسكو في المسائل المتصلة بفتح الباحة الخلفية لروسيا أمام امتداد الحلف الاطلسي فحسب، بل كان القصف الجورجي العشوائي لعاصمة أوسيتيا الجنوبية بمثابة إلقاء قفاز التحدّي في وجه موسكو، التي كانت في الأصل تتحرّق لاستقبال ذلك القفاز. وقبل شهر فقط كانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تقوم بزيارة العاصمة الجورجية تبليسي، لكي تدشن الخطوة الأولى على درب انضمام جورجيا إلى الأطلسي من جانب أوّل، ولكي تعطي إطاراً سياسياً ودبلوماسياً لتلك المناورات العسكرية الأمريكية ـ الجورجية المشتركة، التي أشرف على تنفيذها قرابة 1000 عسكري أمريكي.
وفي استعراض تاريخ النفاق الأمريكي والكيل بأكثر من مكيال إزاء المسائل المتماثلة، لم يكن مدهشاً أن تسكت واشنطن عن الإستفزازات العسكرية الجورجية، وأن تندب في الآن ذاته لجوء موسكو إلى القوّة العسكرية؛ أو، في تتمة اخرى مضحكة ـ مبكية، أنظروا إلى واشنطن تعيب على موسكو ‘الإستخدام غير المتناسب’ للقوّة، وكأنّ البنتاغون استخدم مبدأ القوّة المتناسبة في غزو أفغانستان والعراق! أو كأنّ موسكو، وليس واشنطن، هي صاحبة عشرات القواعد العسكرية الدائمة في طول العالم وعرضه، وعشرات الأساطيل الجاهزة أبداً للتدخل والغزو! واليوم، بعد اتضاح الخسران المبين للخيارات الأمريكية في جورجيا، وبعد إنفاق ما يزيد عن ملياري دولار أمريكي في تسليح جيشها بدل تنمية اقتصادها، لم يجد بوش ما يفعله سوى إرسال المزيد من الأساطيل، حتى إذا شاء تمويهها تحت قناع المساعدات الإنسانية (ساكاشفيلي كان أصدق في الواقع، لأنه بادر فوراً إلى زفّ البشرى إلى الشارع الجورجي المصاب باليأس والإحباط والذعر: هذا يعني وضع موانىء ومطارات جورجيا تحت الوصاية الأمريكية!). أمّا ما يعنيه قرار البيت الأبيض عسكرياً، فهو ببساطة نشر مئات أو ربما آلاف الجنود الأمريكيين خارج الولايات المتحدة، لا لشيء إلا لأنّ وزارة الدفاع هي الجهة التي كُلّفت بنقل وإيصال تلك ‘المساعدات’.
هل ما يجري هو استئناف، على نحو أو آخر، للحرب الباردة العتيقة إياها، التي تمّ نعيها مراراً دون أن تُدفن تماماً؟ وهل نأخذ على محمل الجدّ تلك التعليقات النارية التي أخذت تطفح بها أعمدة الصحف الأمريكية، الداعية إلى تلقين روسيا فلاديمير بوتين (دائماً، وكأنّ ديمتري مدفيديف ليس الرئيس الفعلي!) سلسلة دروس في حسن السلوك، بما في ذلك تذكيره بأنّ الحلف الاطلسي أقرب إلى موسكو من حبل الوريد؟ قبل سنوات قليلة كان جورج روبرتسون، الأمين العام السابق للـ ‘ناتو’، قد تفاخر بأنّ الحلف بات يضمّ دولاً تمتدّ مساحتها من فانكوفر في كندا إلى فلاديفوستوك شرق روسيا. من جانبه اعتبر بوش أنّ الحرب الباردة انتهت الآن فقط، مع صدور إعلان روما الذي تضمّن تشكيل المنتدى الأمني الجديد بعضوية دول حلف شمال الأطلسي التسع عشرة، بالإضافة إلى روسيا. في عبارة أخرى، لم تنتهِ الحرب الباردة على يد جورج بوش الأب وميخائيل غورباتشوف، بل على يد جورج بوش الابن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذه، بالطبع، إشكالية زائفة سوف يحسمها التاريخ إذا وضعت الحرب الباردة أوزارها ذات يوم، بصرف النظر عن أيّ اتفاق قديم أو وشيك بين قادة 20 دولة أورو ـ أمريكية متقدّمة مصنّعة على الأطروحة الأمريكية التي تقول إنّ الشراكة الأمنية الجديدة تواجه عدوّاً شرساً جديداً هو ‘الإرهاب الدولي’، أين منه دول حلف وارسو وإمبراطوريات الشرّ والستار الحديدي. كذلك بات من الجلي اليوم أنّ انضمام روسيا إلى المنتدى الجديد لم يكن أكثر من إجراء وقائي ـ تجميلي يستهدف التطويق أكثر من الإشراك، وذلك حين تنصّ قوانين المجلس الجديد على أنّ كلّ دولة عضو أصيل في الحلف تملك حقّ استبعاد روسيا من مناقشة أيّة قضية أمنية ذات حساسية خاصة ولا تحظى بإجماع الدول الأعضاء! لكنّ سلسلة مآزق روسيا لا يختزلها أيّ طراز من التباهي حول رفعة روسيا نووياً، حين تكون رفعتها الجيو ـ سياسية والإقتصادية أكثر تواضعاً وانحطاطاً. وفي روسيا، وليس في طاجكستان أو تركستان أو جورجيا أو أوكرانيا، يلجأ الملايين من عمّال المناجم إلى سلاح الإضراب المفتوح، لا من أجل زيادة الأجور أو تحسين شروط العمل أو تحقيق مطالب مهنية، بل ببساطة من أجل استلام الأجور ذاتها، ليس أكثر! وفي روسيا انحدار متواصل لمستوى المعيشة، وتآكل ثابت في القدرة الشرائية، وفشل متواصل في الخطط الاقتصادية، وتضخّم وعجز وبطالة وعصابات مافيا.
أليس من المؤشرات الباعثة على القلق أنّ أحداث روسيا تراجعت وتتراجع إلى مراتب دنيا في لوائح اهتمام العالم بما يجري في بقاع ومناطق ومراكز هذا العالم؟ أليس مقلقاً أنّ هذا التراجع يطال دولة ما تزال القوّة العظمى الثانية، نووياً على الأقل، وما تزال مرشحة للعب دور القطب الثاني الموازي للقطب الأمريكي الأول، أياً كان معنى القطبية هنا؟ ألا يرتاب المرء في أنّ الثنائي مدفيديف ـ بوتين سارعا إلى الوحول الجورجية لأنّ اللعبة الإمبريالية الأمريكية ـ الأطلسية، المتجددة فقط لأنها ليست جديدة، توشك على نسف مفهوم القطبية… مرّة وإلى الأبد؟ وبصرف النظر عن يقين المرء بأنّ إضعاف روسيا يظلّ هدفاً ستراتيجياً أمريكياً ـ أطلسياً، ألا تبدو روسيا بدايات القرن الحادي والعشرين وكأنها ترتدّ إلى روسيا أوائل القرن العشرين، أو كأنّ صورة البلد تقفز من إحدى روايات دستويفسكي: رعب وعنف وتمرّد، وجثث مجهولة لا تحتضنها سوى الثلوج اللامتناهية، وقلق غامض يكتنف قوى أكثر غموضاً، وأكوام من الروبلات (وليس الكوبيكات) لا تكاد تبتاع رغيف خبز أسود أو زجاجة فودكا من الصنف الرديء؟ وإذ تعود هذه الأيام إلى ما يشبه المربّع الأول في الحسابات الدولية الجيو ـ سياسية، فذلك لأنها تعود من بوّابة واحدة وحيدة هي كاريكاتور التحديث الليبرالي، الذي يتجلّى في صورته الأكثر بشاعة وإثارة للرعب: مخلوق ديناصوري نووي اغترب عن هويته وعن أطرافه الجغرافية والسكانية (25 مليون مواطن روسي يقيمون في بلدان الجوار غير الروسية)، لا يستطيع التقدّم خطوة إلى الأمام إلا إذا توقّف في المكان بمعدّل زمني يساوي خطوتين إلى الوراء. وهو مخلوق عاجز عن مجاراة أعدائه الرأسماليين القدماء، تماماً مثل عجزه عن مجاراة حلفائه الشيوعيين القدماء (الصين بصفة خاصة). ولا يكون أمامه، كما في مثال جورجيا، إلا أن يجاري خصمه السابق الأمريكي: غزو، بعد استخدام القوّة غير المتناسبة.
وجوزيف جوفي، في مقالته المشار إليها أعلاه، يلجأ إلى الطرافة السوداء حين يتساءل: ‘مهلاً، ألسنا في القرن الحادي والعشرين؟ في حساب الزمن، نعم. ولكن روسيا ـ تماماً على شاكلة العالِم المعتوه إيميت براون في فيلم ‘عودة إلى المستقبل’ ـ يقذف بنا القهقرى 150 سنة في القوقاز: إلى عصر الإمبريالية والجيو ـ سياسية وحروب الطاقة وميادين النفوذ’. نعم، كلّ هذه الطرافة جادّة بالطبع، شرط أن تنطبق كامل معطياتها على الرهط في البيت الأبيض، قبل الكرملين! ‘
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس




